الفهرس
الصورة

ص: 335
الطبعة الأولى
2009-
1430ه
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الناشر
مكتبة الثقافة الدينية
526 شارع بورسعيد - القاهرة
فاکس:25936277/25938411-25922620
E-mail: alsakafa_aldinay@hotmail.com
بطاقة الفهرسة
إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية
امام الحرمين ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ،1028-1685
كتاب الارشاد الى تواضع الادلة فى اصول الاعتقاد / للجويني
ظبط وتحقيق : احمد عبد الرحيم السايح ، توفيق على وهبة
القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية ، 2009
، 24 سم
تدمك : 3-418-341-977
1- علم الكلام
2- الأمر بالمعروف
ب السايح ، احمد عبد الرحيم (مقدم)
ج- وهبة توفيق على (مقدم مشارك )
ب-العنوان
ديوي: 240
رقم الايداع : 7644
ص: 1
المكتبة الفلسفية
کتاب الارشاد
إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد
لإمام الحرمين الجويني
(٤١٩ - ٤٧٨ه_ )
ضبط و تحقيق
الأستاذ الدكتور :أحمد عبد الرحيم السايح
المستشار:توفين على وهبة
الناشر
مكتبة الثقافة الدينية
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الذي أنعم على المؤمنين بنعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وصحبه أجمعين.
أما بعد...
فمما يحسن أن يدرك أن علماء الكلام في المجتمع الإسلامي هم تصدوا لإبراز الجوانب العقدية، وإيضاح أدلتها. عقلا ونقلا. وليكن معلومًا أن علماء الأمة هم الذين نشروا الإسلام عن طريق المناظرات ومجالس العلم.
فقد كان عمرو بن عبيد يناظر ويحاور العلماء في مجتمعات ما وراء النهر حتى أقنع آلاف الناس بالدخول في الإسلام والذين يحاولون إبعاد الناس عن علم الكلام مخطئون وبعيدون عن المنهج الإسلامي. وقد يكونون عملاء لأعداء الأمة لأن مواجهة التحديات الفكرية لا تكون إلا عن طريق أساليب علم الكلام ومعياريته.
في مرة قال الدكتور أحمد السايح لباحث كيف تحاور عالما ملحدا؟ فقال الباحث أقول له قال الله تعالى كذا فقال الدكتور السايح إذا كان هو غير مؤمن بالله فوقف الباحث.
إذن هؤلاء لا يعرفون كيف يكون الحوار، وكيف تكون المناظرة. ن المناظرة.
ص: 3
وكثير ممن تلقوا العلم الديني لا يعرفون إلا قال قرادة وقال أبو جهل دون إدراك أو فهم أو وعي.
وهذا ولا شك - هو سبب تأخر المجتمع الإسلامي عن ركب الحضارة والمساهمة الفاعلة العاقلة.
وأصبح المسلمون عالة على مجتمعات كثيرة؛ فالخطاب الديني خطاب بعيد عن قيم حب الدنيا والعقلانية الواعية والفلسفة الفاعلة.
إن الأمة الإسلامية تحتاج إلى قواطع الأدلة التي تنبه العقول، وتوقظ في الإنسان الوعي الثلاثي المنطلق من قوله تعالى: {والله أخركم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون} .
والإمام الجويني إمام الحرمين صنف كتابه «قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ليكون ضياء أمام الباحثين والدارسين.
وإن الأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى هذه المؤلفات لتتعرف على الطريق الصحيح، وتحاول جاهدة أن تتمسك بالقيم الهادفة.
وقد رأينا أن تقدم هذا السفر الجليل إلى المكتبة العربية، فراجعنا مخطوطات الكتاب، وما طبع منه نسأل الله التوفيق والسداد.
أ.د أحمد عبد الرحيم السايح
المستشار توفيق علي وهبه
ص: 4
مولده ونشأته:
ولد الجويني في ١٨ من المحرم ٤١٩ ه_ - ١٢ من فبراير ١٠٢٨م، في بيت غرف بالعلم والتدين؛ فقد كان أبوه «عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيويه واحدا من علماء نيسابور المعروفين، وأحد فقهاء المذهب الشافعي، وله مؤلفات كثيرة في التفسير والفقه والعقائد والعبادات، وقد اشتهر بحبه الشديد للعمل، كما عرف بالصلاح والورع، ومن ثم فقد حرص على تنشئة ابنه «عبد الملك» تنشئة إسلامية صحيحة في جو من العلم والأدب والثقافة الإسلامية.
وكان مثالا أو قدوة احتذى بها ابنه في كثير من الصفات، وحرص الأب على أن يعلم ابنه بنفسه منذ حداثة سنه ؛ فدَرَّس له الفقه والعربية وعلومها، واجتهد في تعليمه الفقه والخلاف والأصول واستطاع الجويني أن يحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وكان يحضر مجالس والده حتى برز على أقرانه، وتفوق على كثير ممن كانوا يتلقون العلم في مدرسة أبيه، وقد ساعده على ذلك ما حباه الله به من عقل راجح، وذهن موقد، وحافظة قوية، مع حبه للعلم وشغفه بالاطلاع والبحث.
ص: 5
الجويني بين الدرس والتدريس
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد
وكان الجويني ذا روح وثابة إلى الحق والمعرفة يميل إلى البحث والنقد والاستقصاء؛ فلا يقبل ما يأباه عقله، ويرفض ما بدا له فيه أدنى شبهة أو ريبة، وظل الجويني ينهل من العلم والمعرفة في شغف ودأب شديدين حتى صار من أئمة عصره المعروفين، وهو لم يتجاوز العشرين من عمره، فلما توفي أبوه جلس مكانه للتدريس وهو في تلك السن المبكرة؛ فكان يدرس المذهب الشافعي ويدافع عن العقيدة الأشعرية، ولكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في البحث ومواصلة التحصيل والاطلاع، فكان تلميذا وأستاذاً في آن واحد.
شيوخه وأساتذته:
ومع أن والده كان هو المعلم الأول في حياته، فإن ذلك لم يمنعه من التلقي على مشاهير علماء عصر ه؛ فأخذ علوم الفقه عن أبي القاسم الإسفراييني»، كما تلقى علوم القرآن الكريم على يد أبي عبد الله محمد بن علي النيسابوري الجنازي والذي عرف بشيخ القراء وغيرهم.
الرحيل إلى الحجاز
كان نجم الجويني قد بدأ يلمع في نيسابور وما حولها، وانتشر صيته حتى بلغ العراق والشام والحجاز ومصر، لكنه تعرض لبعض العنت والتضييق فاضطر إلى مغادرة نيسابور، وما لبث أن رحل إلى الحجاز فأقام بمكة وظل بها أربع سنوات يدرس ويفتي ويناظر حتى لقبه الناس «إمام الحرمين» لعلمه
ص: 6
واجتهاده، فكان يقضي يومه بين العلم والتدريس ويقيم ليله طائفا متعبدا في الكعبة المشرفة، فصفت نفسه، وعلت همته، وارتفع قدره.
* الجويني والتصوف:
وقد عرف التصوف الحق طريقه إلى قلب الجويني، فكان مجالسه الصوفية رياضة روحية وسياحة نفسية يحلق بها في آفاق إيمانية وحبه، يبكي فيبكي الحاضرون لبكائه، ويجد فيها مجاهدة لنفسه ومراجعة لها.
* العودة إلى نيسابور :
وعاد الجويني مرة أخرى إلى نيسابور، حيث قام بالتدريس في المدرسة النظامية التي أنشأها له الوزير «نظام الملك» لتدريس المذهب السني.
وظل الإمام الجويني يدرس بالمدرسة النظامية، فذاع صيته بين العلماء، وقصده الطلاب والدارسون من البلاد الأخرى.
وكانت هذه الفترة من أخصب الفترات في حياة الإمام؛ ففيها بلغ أوج نضجها العلمي، وصنف الكثير من مؤلفاته.
* آثاره ومؤلفاته
ومؤلفات الجويني على كثرتها لم تنل القدر الملائم لها من العناية والاهتمام من قبل الباحثين والمحققين، فمعظمها لا يزال مخطوطا، ولم يطبع منها إلا بعدد قليل منها :
ص: 7
- الإرشاد على قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد.
- البرهان في أصول الفقه.
-الرسالة النظامية (أو العقيدة النظامية).
- الشامل في أصول الدين.
- غياث الأمم في التياث الظلم.
-لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة.
- الورقات في أصول الفقه.
وبرغم ما عرف به الجويني من غزارة العلم وما اتسم به من رجاحة العقل وحب العلم، وما بذله من جهد صادق في خدمة الدين، فإنه كان هدفا لبعض الطاغين عليه الذين حاولوا النيل من علمه والتشكيك في صحة عقيدته، وذلك من خلال أقوال اقتطعوها من كلامه وأخرجوها من سياقها، وراحوا يفسرونها على هواهم، وفق ما أرادوا توجيهها إليه، ولكنها اتهامات مرسلة، ومطاعن واهية لا تستند إلى حقائق علمية.
نهاية الرحلة :
وبعد رحلة حياة حافلة بالعلم والعطاء، أصيب الجويني بعلة شديدة، فلما أحس بوطأة المرض عليه انتقل إلى «بشتنقان» للإستشفاء بجوها المعتدل،
ص: 8
ولكن اشتد عليه المرض فمات بها، وذلك في مساء الأربعاء ٢٥ من ربيع الآخر ٤٧٨٠ ه_ - ٢٠ من أغسطس ١١٨٥ م ، عن عمره بلغ تسعا وخمسين عاما.
ص: 9
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله.
الحمد الله بارئ النسم ومحيي الرمم، ومقدر القسم، ومفرق الأمم إلى الهداية للطريق الأمم والخذلان باقتراف الزلل والملمم.
موضح الحق بواضحات الدلائل ومزهق الكفر والباطل، ومبتعث الرسول صلى الله عليه وسلم على حين ضلال من الخلق وفتور من الحق، بشيرًا ونذيرا ، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا.
هذا، ولما رأينا أدلة التوحيد عصاما للتسديد ورباطا لأسباب التأييد؛ وألقينا الكتب المبسوطة المحتوية على القواطع الساطعة، والبراهين الصادعة، لا تنهض لدركها همم أهل هذا الزمان، وصادفنا المعتقدات عرية عن قواطع البرهان.
رأينا أن نسلك مسلكا يشتمل على الأدلة القطعية والقضايا العقلية، متعلّيا عن رتب ،المعتقدات منحطا عن جلة المصنفات. والله ولي الإعانة والتوفيق، وهو بالفضل حقيق.
ص: 10
أول ما يجب على العاقل البالغ، باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا، القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم. و النظر في اصطلاح الموحدين، هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن. ثم ينقسم النظر قسمين: إلى الصحيح، و إلى الفاسد؛ و الصحيح منه كل ما يؤدي إلى العثور على الوجه الذي منه يدل الدليل؛ و الفاسد ما عداه. ثم قد يفسد النظر بحيده عن سنن الدليل أصلا، و قد يفسد مع استناده للسداد أولا لطروء قاطع.
فإن قيل: قد أنكرت طائفة من الأوائل إفضاء النظر إلى العلم، و زعموا أن مدارك العلوم الحواس، فكيف السبيل إلى مكالمتهم؟ قلنا: الوجه أن نقسم الكلام عليهم، فنقول: هل تزعمون أنكم عالمون بفساد النظر، أو تستريبون فيه؟ فإن قطعوا بفساد النظر، فقد ناقضوا نص مذهبهم في حصر مدارك العلوم في الحواس، إذ العلم بفساد النظر خارج عن قبيل المحسوسات.
ثم نقول: أعلمتم فساد النظر ضرورة، أم علمتموه نظرا؟ فإن زعموا أنهم علموه ضرورة كانوا مباهتين، ثم لا يسلمون عن مقابلة دعواهم بنقيضها. و إن زعموا أنهم أدركوا فساد النظر بالنظر، فقد ناقضوا كلامهم؛
ص: 11
حيث نفوا جملة النظر و قضوا بأنه لا يؤدي إلى العلم، ثم تمسكوا بنوع من النظر، و اعترفوا بكونه مفضيا إلى العلم.
و إن قالوا: أنتم إذا أثبتم النظر و ادعيتم أداءه إلى العلم، أ تسندون دعواكم إلى الضرورة، أو تسندونها إلى النظر؟ فإن ادعيتم الضرورة لزمكم ما ألزمتمونا و انعكس عليكم مرامكم؛ و إن حكمتم بصحة النظر بالنظر فقد أثبتم الشي ء بنفسه، و ذلك مستحيل. قلنا: كلامكم هذا يفيدكم شيئا، أو لا يفيدكم شيئا أصلا؟ فإن زعموا أنه لا يفيد علما و لا يجلب حكما، فقد اعترفوا بكونه لغوا، و كفونا مئونة الجواب.
و إن زعموا أنه يفيد العلم بفساد دليلنا، فقد تمسكوا بضرب من النظر في سياق إنكار جميعه.
و إن قالوا: غرضنا مقابلة الفاسد بالفاسد، رددنا عليهم التقسيم، و قلنا: معارضة الفاسد بالفاسد من وجوه النظر. ثم نقول: لا بعد في إثبات جميع أنواع النظر بنوع منها يثبت نفسه و غيره، و هذا كالعلم يتعلق بالمعلومات و يتعلق بنفسه؛ إذ بالعلم يعلم العلم، كما به يعلم سائر المعلومات.
و إن قال السائل: لست قاطعا ببطلان النظر فيطرد عليّ تقسيمكم، و إنما أنا مستريب مسترشد؛ فالوجه أن يقال لمن رام إرشادا: سبيلك أن تنظر في الأدلة نظرا قويما، و تنهج فيها نهجا مستقيما؛
ص: 12
فإذا صح منك النظر، و استدّت «1» منك العبر، أفضت بك إلى العلم. و إن نظر كما رسم له، و أنكر أداء صحيح النظر إلى العلم، فقد تبين عناده، و سقط استرشاده.
النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، و يضاد الجهل به، و الشك فيه. فوجه مضادته للعلم أنه بحث عنه و ابتغاء توصل إليه، و ذلك يناقض تحقق العلم، إذ الحاصل لا يبتغى. و سبيل مضادته للجهل، أن الجهل اعتقاد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به، و الموصوف به مصمم عليه، و ذلك يناقض التطلب و البحث. و التشكك تردد بين معتقدين، و النظر بغية للحق. فهو إذا مضاد للعلم و جملة أضداده.
النظر الصحيح إذا تمّ على سداده، و لم تعقبه آفة تنافي العلم، حصل العلم بالمنظور فيه على الاتصال بتصرّم النظر. و لا يتأتى من الناظر جهل بالمدلول عقيب النظر مع ذكره له، و لا يولّد النظر العلم، «و لا يوجبه إيجاب العلة معلولها». و زعمت المعتزلة «2» أنه يولده. و وافقونا على أن تذاكر النظر لا يولد العلم، و إن كان يتضمنه. و سيرد أصل التولد في موضعه إن شاء اللّه عز و جل.
ص: 13
فإن قالوا: إذا كان النظر لا يولد العلم، و لا يوجبه إيجاب العلة معلولها، فما معنى تضمنه له؟
قلنا: المراد بذلك أن النظر الصحيح إذا استبق، و انتفت الآفاق بعده، فيتيقن عقلا ثبوت العلم بالمنظور فيه؛ فثبوتهما كذلك حتم من غير أن يوجب أحدهما الثاني أو يوجده أو يولده، فسبيلهما كسبيل الإرادة لشي ء مع العلم به، إذ لا تتحقق إرادة الشي ء من غير علم به. ثم تلازمهما لا يقضي بكون أحدهما موجدا، أو موجبا، أو مولدا.
النظر الصحيح يتضمن العلم كما سبق، و النظر الفاسد لا يتضمن علما، و كما لا يتضمنه فكذلك لا يتضمن جهلا و لا ضدا من أضداد العلم سواه؛ فإن النظر الصحيح يطلع الناظر على وجه الدليل المقتضي للعلم بالمدلول. و إذا فسد النظر بمصادفة الشبهة، فليس للشبهة وجه متعلق باعتقاد على التحقيق؛ إذ لو كان للشبهة وجه متعلق باعتقاد على التحقيق، لكان دليلا، و لكان الاعتقاد علما.
و مما يوضح ذلك، أن الدليل لما دل بصفته النفسية، دل كل من أحاط به علما على مدلوله؛
ص: 14
فلو كان للشبهة وجه أيضا، لقاد العالم بحقيقة الشبهة إلى الجهل، و ليس الأمر كذلك.
الأدلة هي التي يتوصل بصحيح النظر فيها إلى ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، و هي تنقسم إلى العقلي و السمعي.
فأما العقلي من الأدلة، فما دل بصفة لازمة هو في نفسه عليها، و لا يتقرر في العقل تقدير وجوده غير دال على مدلوله؛ كالحادث الدال بجواز وجوده على مقتض يخصصه بالوجود الجائز، و كذلك الإتقان و التخصيص الدالان على علم المتقن و إرادة المخصص.
و السمعي، هو الذي يستند إلى خبر صدق أو أمر يجب اتباعه.
النظر الموصل إلى المعارف واجب، و مدرك وجوبه الشرع، و جملة أحكام التكليف متلقاة من الأدلة السمعية و القضايا الشرعية.
و ذهبت المعتزلة إلى أن العقل يتوصل به إلى درك واجبات، و من جملتها النظر، فيعلم وجوبه عندهم عقلا، و ستأتي المسألة إن شاء اللّه عز و جل، و لكنا نذكر منها طرفا يختص بالنظر.
ص: 15
فإن قالوا: إذا نفيتم مدرك وجوب النظر عقلا، ففي مصيركم إلى ذلك إبطال تحدي الأنبياء عليهم السلام، و انحسام سبيل الاحتجاج؛ فإنهم إذا دعوا الخلق إلى ما ظهر من أمرهم، و استدعوا منهم النظر فيما أبدوه من المعجزات، و خصّصوا به من الآيات، فيقال لهم: لا يجب النظر إلا بشرع مستقر، و تكليف ثابت مستمر، و لم يثبت بعد عندنا شرع تتلقى منه الواجبات؛ فيحملهم هذا الاعتقاد على الإضراب عن الرشاد، و التمادي في الجحد و العناد.
قلنا: هذا الرأي الذي ألزمتمونا في الشرع المنقول ينعكس عليكم في قضايا العقول؛ فإن الموصل إلى العلم بوجوب النظر من مجاري العبر، و عندكم أن العاقل يخطر له تجويز صانع يطلب منه معرفته و شكره على نعمه، و لو عرفه لنجا و رجا الثواب الجزيل، و لو كفر و استكبر لتصدى لاستحقاق العقاب الوبيل.
فإذا تقابل عنده الجائزان، و تعارض لديه الاحتمالان، و هو يتوقع في التمسك بأحدهما التعرض للنعيم المقيم، و يرقب في ملابسة الثاني استيجاب العذاب الأليم، فالعقل يقضي باختيار سبيل النجاة، و إيثار تجنب المهلكات.
ص: 16
فإذا كان السبيل المفضي إلى العلم بوجوب النظر اختلاج الخواطر في النفس، و تعارض الجائزات في الحدس، فمن ذهل عن هذه الخواطر، و غفل عن هذه الضمائر، فلا يكون عالما بوجوب النظر.
و يلزم الخصوم في مدارك العقول، عند الغفلة و الذهول، ما ألزمونا في مقتضى الشرع المنقول. و ما ألزمناهم من فرض الكلام عند عدم الخاطرين يناظر ادعاء النبوة مع عدم المعجزة، فلزمهم العكس و لم يلزمنا ما قالوه فإن المعجزة إذا ظهرت و تمكن العاقل من دركها، كانت بمثابة جريان الخاطرين على زعم الخصم؛ فإذا جريا، فإمكان النظر في اختيار أحدهما كإمكان النظر في المعجزة عند ظهورها.
ثم نقول: شرط الوجوب عندنا، ثبوت السمع الدال عليه، مع تمكن المكلف من الوصول إليه. فإذا ظهرت المعجزات، و دلت على صدق الرسل الدلالات، فقد تقرر الشرع و استمر السمع المنبى ء عن وجوب الواجبات و حظر المحظورات. و لا يتوقف وجوب الشي ء على علم المكلف به، و لكن الشرط تمكن المخاطب من تحصيل العلم به.
ص: 17
فإن قيل: ما الدال على وجوب النظر و الاستدلال من جهة الشرع؟ قلنا: أجمعت الأمة على وجوب معرفة الباري تعالى، و استبان بالعقل أنه لا يتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظر، و ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب.
العلم معرفة المعلوم على ما هو به وهذا أولى في روم تحديد العمل من ألفاظ مأثورة عن بعض أصحابنا في حد العلم.
منها قول بعضهم: العلم تبين المعلوم على ما هو به.
ومنها قول شيخنا رحمه الله : العلم ما أوجب كون محله عالما.
ومنها قول طائفة : العلم ما يصح ممن اتصف به إحكام الفعل وإتقانه.
فأما قول من قال: هو تبين المعلوم على ما هو به فمرغوب عنه، إذ التبين ينبئ عن الإحاطة بالمعلوم عن جهل أو غفلة، إذ يقول من علم ما لم يكن عالماً به، قد تبينته.
وغرضنا من الحد ذكر ما يشتمل على العلم القديم الحادث.
ولا نرتضي أيضًا حد العمل بأنه الذي أوجب لمحله كونه عالما فإن الغرض من الحدود تبيين المقصود، وهذا فيه إجمال.
ص: 18
إذ قد يجري عروضه ومثله في كل معني يسأل المرء عن حده..
ولا يصح أيضًا تحديد العمل بما يصح من الموصوف به الإحكام، فإن العلم بالمستحيلات والقديم والموجودات الباقية لا يصح من الموصوف بها الإحكام.
وإنما يتدرج تحت ما قاله هذا القائل ضرب واحد من العلوم وهو العلم بالإتقان والإحكام.
وأما أوائل المعتزلة فقد قالوا في حد العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع توطين النفس، فأبطل عليهم حدهم باعتقاد المقلد ثبوت الصانع.
فإنه اعتقاد المعتقد على ما هو به مع سكون النفس إلى المعتقد، ثم هو ليس بعلم.
فزاد المتأخرون فقالوا: هو اعتقاد الشيء على ما هو به، مع توطين النفس إلى المعتقد إذا وقع ضرورة أو نظرا.
وهذا يبطل بالعلم بأن لا شريك الله تعالى والعلم بالمستحيلات كاجتماع المتضادات ،ونحوها، فهذه ونحوها علوم.
وليست علوما بأشياء، إذ الشيء هو الموجود عندنا، وهو الموجود والمعدوم الذي يصح وجوده عندهم، فقد شذت علوم عن الحد.
ص: 19
العلم ينقسم إلى القديم و الحادث. فالعلم القديم صفة الباري تعالى القائم بذاته، المتعلق بالمعلومات غير المتناهية، الموجب للرب سبحانه و تعالى حكم الإحاطة المتقدس عن كونه ضروريا أو كسبيا.
و العلم الحادث ينقسم إلى الضروري، و البديهي، و الكسبي. فالضروري هو العلم الحادث غير المقدور للعبد مع الاقتران بضرر أو حاجة، و البديهي كالضروري غير أنه لا يقترن بضرر و لا حاجة، و قد يسمى كل واحد من هذين القسمين باسم الثاني. و من حكم الضروري في مستقر العادة أن يتوالى فلا يتأتى الانفكاك عنه و التشكك فيه؛ و ذلك كالعلم بالمدركات، و علم المرء بنفسه، و العلم باستحالة اجتماع المتضادات و نحوها. و العلم الكسبي هو العلم الحادث المقدور بالقدرة الحادثة. ثم كل علم كسبي نظري، و هو الذي يتضمنه النظر الصحيح في الدليل.
هذا، ما استمرت به العادة، و في المقدور إحداث علم و إحداث القدرة عليه من غير تقديم نظر، و لكن العادة مستمرة على أن كل علم كسبي نظري.
ص: 20
للعلوم أضداد تخصها، و أضداد تضادها و تضاد غيرها. فأما الأضداد الخاصة، فمنها الجهل، و هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو به؛ و منها الشك، و هو الاسترابة في معتقدين فصاعدا من غير
ترجيح أحدهما على الثاني؛ و منها الظن، و هو كالشك في التردد، إلا أنه يترجح أحد المعتقدين في حكمه. و الأضداد العامة كالموت، و النوم، و الغفلة، و الغشية؛ فهذه المعاني تضاد العلوم، و تضاد الإرادة، و تضاد أضدادها.
العقل علوم ضرورية. و الدليل على أنه من العلوم الضرورية، استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو عن جميع العلوم.
فإن قيل: المانع من كون العقل خاليا عن العلوم كونه مشروطا ثبوته بثبوت ضروب منها، كالإرادة المشروطة بالعلم بالمراد قلنا: غرضنا أن نتعرض للعقل المشروط في التكليف، إذ العاري منه لا يحيط علما بما يكلف.
ص: 21
فإذا افتقر التكليف إلى إحاطة المكلف بما كلف، و لا يحيط بذلك إلا بعد حصول علوم بمعلومات هي أصول النظر، و لا يتقدم الوصول إلى العلم بالتكليف دونها، فقصدنا ضبط تلك العلوم التي نشترط تقديمها على ابتداء النظر، و سمينا عقلا؛ و تبيين الغرض من العقل يدرأ السؤال. و لسنا ننكر كون العقل من الألفاظ المشتركة المنقسمة إلى معان، و غرضنا منه ما ذكرناه.
و ليس العقل من العلوم النظرية، إذ شرط ابتداء النظر تقدم العقل؛ و ليس العقل جملة العلوم الضرورية، فإن الضرير و من لا يدرك يتصف بالعقل مع انتفاء علوم ضرورية عنه. فاستبان بذلك أن العقل بعض من العلوم الضرورية، و ليس كلها.
و سبيل تعيينه و التنصيص عليه أن يقال: كل علم لا يخلو العاقل منه عند الذكر فيه، و لا يشاركه فيه من ليس بعاقل، فهو العقل. و يخرج من مقتضى السبر أن العقل علوم ضرورية بتجويز الجائزات و استحالة المستحيلات؛ كالعلم باستحالة اجتماع المتضادات، و العلم بأن المعلوم لا يخلو عن النفي أو الإثبات، و العلم بأن الموجود لا يخلو عن الحدوث أو القدم.
ص: 22
اعلموا أرشدكم الله أن الموحدين تواطئوا على عبارات في أغراضهم، ابتغاء منهم لجمع المعاني الكثيرة في العبارات الوجيزة.
فمما يستعملونه، وهو منطوق به لغة وشرعا العالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى وصفة ذاته.
ثم العالم جواهر وأعراض فالجوهر هو المتحيز وكل ذي حجم متحيز. والعرض هو المعنى القائم بالجوهر، كالألوان والطعوم والروائح، والحياة والموت، والعلوم والإرادات والقدر، القائمة بالجواهر.
ومما يطلقونه الأكوان وهي الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق ويجمعها ما يخصص الجوهر بمكان أو تقدير مكان.
والجسم في اصطلاح الموحدين المتألف ؛ فإذا تألف جوهران كانا جسمها، إذ كل واحد مؤتلف مع الثاني.
ثم حدث الجواهر يبني على أصول:
منها: إثبات الأعراض.
ومنها: إثبات حدثها.
ص: 23
ومنها: إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض.
ومنها: إثبات استحالة حوادث لا أول لها.
فإذا ثبتت هذه الأصول ترتب عليها الجواهر لا تسبق الحوادث، وما لا يسبق الحادث حادث.
فأما الأصل الأول، فقد أنكرته طوائف من الملحدة، وهو إثبات الأعراض. وزعموا أن لا موجود إلا الجواهر، والدليل على إثبات الأعراض أنا إذا رأينا جوهرًا ساكنا، ثم رأيناه متحركا مختصا بالجهة التي انتقل إليها، مفارقًا للتي انتقل عنها.
فعلى اضطرار نعلم أن اختصاصه بجهته من الممكنات وليس من الواجبات، إذ لا يستحيل تقدي بقاء الجوهر في الجهة الأولى.
والحكم الجائز ثبوته والجائز انتفاؤه، إذا تخصص بالثبوت بدلا عن الانتفاء المجوّز، افتقر إلى مقتض يقتضي له الاختصاص بالثيوت، وذلك معلوم أيضا على البديهة.
فإذا تقرر ذلك لم يخل المقتضى من أن يكون نفس الجوهر، إذ لو كان كذلك لاختص بالجهة التي فرضنا الكلام فيها ما دامت نفسه، ولاستحال عليه الزوال عنها والانتقال إلى غيرها.
فثبت أن المقتضى زائد على الجوهر، ثم الزائد عليه يستحيل أن يكون عدما ..
ص: 24
إذ لا فرق بين نفي المقتضى وبين تقدير مقتض منفي.
فإذا صح كون المقتضى ثابتاً زائداً على الجوهر، لم يخل من أن يكون مثلا له أو خلافًا، ويبطل أن يكون مثلا له فإن مثل الجوهر جوهر.
ولو اقتضى جوهر اختصاصًا لجوهر غيره بجهة لاستحال اختصاصه بتلك الجهة، مع تقدير انتفاء الجوهر الذي قدر مقتضيا.
وليس الأمر كذلك ثم ليس أحد الجوهرين بأن يكون مقتضيا اختصاصا أولى من الثاني.
فإذا ثبت المقتضى الزائد على الجوهر، وتقرر أنه خلافه، لم يخل من أن يكون فاعلا مختارا، أو معنى موجبا.
فإن كان معنى موجبا، تعين قيامه بالجوهر المختص بجهته، إذ لو لم يكن له به اختصاص لما كان بإيجابه الحكم له أولى من إيجابه لغيره.
والذي وصفناه هو الغرض الذي ابتغيناه.
وإن قدّر مقدّر المخصص فاعلا، والكلام في جوهر مستمر الوجود، كان ذلك محالا؛ إذ الباقي لا يفعل.
ولا بد للفاعل من فعل فخرج من مضمون ذلك ثبوت الأعراض، وهو من أهم الأغراض في إثبات حدث العالم.
ص: 25
والأصل الثاني: إثبات حدث الأعراض، والغرض من ذلك يترتب على أصول.
منها : إيضاح استحالة عدم القديم.
ومنها: استحالة عدم قيام الأعراض بأنفسها واستحالة انتقالها.
ومنها: الرد على القائلين بالكمون والظهور والأولى أن تطرد دلالة في حدث الأعراض.
ونورد هذه الأصول في معرض الأسئلة، ونثبت المقاصد منها في معرض الأجوبة، فنقول:
الجوهر الساكن إذا تحرك فقد طرأت عليه الحركة، ودل طروءها على حدوثها، وانتفاء السكون بطروئها يقضي بحدث السكون إذ لو ثبت قدمه لاستحال عدمه.
فإن قيل: بم تُنكرون على من يزعم أن الحركة كانت كامنة في الجوهر، ثم ظهرت وانكمن لظهورها السكون.
قلنا: لو كان كذلك لاجتمع الضدان في المحل الواحد. وكما نعلم استحالة كون الشيء متحركا ساكنا، فكذلك نعلم استحالة اجتماع الحركة والسكون.
ثم لو ظهرت الحركة والسكون مرَّة واستكنَّتْ أخرى، لكان ذلك اعتوار حكمين عليه، وذلك يتضمن ثبوت معنيين، يقتضى أحدهما كون الحركة بادية
ص: 26
ويقضى الآخر كونها مستكنة خافية، فإن الدال على إثبات الأعراض تناوب الأحكام وتعاقبها على الجواهر.
ثم يلزم لو قدرنا الظهور والكمون معنيين.
ظهورهما عند طهور أثرهما ، ككمونهما عند كمون أثرهما، ويتسلسل القول في ذلك ثم الحركة توجب كون محلها متحركا لعينها.
فلو جاز ثبوتها من غير أن توجب حكمها للزم تجويز ذلك أبدًا فيها، وذلك يقلب جنسها، ويحيل حقيقة نفسها.
فإن قيل: ما الدليل على استحالة عدم القديم؟ قلنا: الدليل عليه أن عدمه في وقت مفروض يستحيل أن يكون واجبًا، حتى يمتنع تقدير استمرار الوجود الأزلي فيه.
وهذا معلوم بطلانه ببديهة العقل، فلو قدر في وقت مفروض عدم جائز، مع تجويز استمرار الوجود بدلا عنه من غير مقتض، كان ذلك محالا.
إذ الجائز يفتقر إلى مقتض، والعدم نفي محض يستحيل تعليقه بفاعل مخصص.
ويستحيل أيضًا حمل العدم على طريان ضد.
ص: 27
فإن الطارئ ليس هو بمضادة القديم أولى من القديم يمنع ما قُدِّر ضدا له من الطروء.
ولا يجوز استناد عدم القديم إلى انتفاء شرط من شرائط استمرار وجود القديم.
إذ لو قدر لوجود القديم شرط لكان قديما مفتقرا عدمه لو قدر إلى مقتض، ثم يتسلسل القول.
فإن قيل : أحد أركان الدليل على حدث الأعراض مبنى على منع انتقالها، فما الدليل على منع انتقالها؟
إذ للقائل أن يقول : الحركة الطارئة على جوهر منتقلة إليه من جوهر آخر. فالجواب أن الحركة حقيقتها الانتقال فينبغي أن تقتضي ما وُجدت انتقال جوهر بها، ولو انتقلت من جوهر إلى آخر للزم طريان حالة عليها لا تكون فيها انتقالا.
وذلك قلب الجنسها، وانقلاب الأجناس محال؛ ولو انتقل الانتقال لافتقر إلى انتقال.
ثم كذلك القول في الانتقال المنتقل إلى الانتقال، وذلك يفضي إلى ما لا يتناهى. فقد ثبت بمجموع ما ذكرناه حدث الأعراض والأصول المرتبطة به.
ص: 28
وأما الأصل الثالث فهو تبيين استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، فالذي صار إليه أهل الحق أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن جميع أضداده، إن كان له أضداد، وإن كان له ضد واحد، لم يخل الجوهر عن أحد الضدين.
فإن قدر عرض لا ضدّ له، لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه.
وجوزت الملحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض.
والجواهر في اصطلاحهم تسمى الهيولى والأعراض تسمى الصورة. وجوز الصالحي(1) الخل عن جملة الأعراض ابتداء.
ومنع البصريون من المعتزلة العرو عن الأكوان، وجوزوا الخلو عن ما عداها.
وقال الكعبي ومتبعوه(2): يجوز الخلو عن الأكوان ويمتنع العروّ عن الألوان، وكل مخالف لنا يوافقنا على امتناع العرو عن الأعراض، بعد قبول الجواهر لها.
ص: 29
فيفرض الكلام مع الملحدة في الأكوان فإن القول فيها يستند إلى الضرورة.
فإننا ببديهة العقل نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا نعقل غير متماسة ولا متباينة.
ومما يوضح ذلك، أنها إذا اجتمعت فيما لم يزل فلا يتقرر في العقل اجتماعها إلا عن افتراق سابق، إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع، وكذلك إذا طرأ
الافتراق عليها، اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع.
وغرضنا في روم إثبات حدث العالم يتضح بثبوت الأكوان فإن حاولنا ردا على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسبكنا بنكتتين:
إحداهما الاستشهاد بالإجماع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها.
فنقول : كل عرض باق فإنه ينتفي عن محله بطريان ضد فيه ثم الضد إنما يطرأ في حال عدم المنتفي به على زعمهم.
فإذا انتفى البياض فهلا جاز أن لا يحدث بعد انتفائه لون، إن كان يجوز تقدير الخلو من الألوان ابتداء، ونطرد هذه الطريقة في أجناس الأعراض.
ونقول أيضا الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى؛ أنه لو قامت به لم يخل عنها، وذلك يفضي لحدثه.
ص: 30
فإذا جوز الخصم عروّ الجوهر عن الحوادث، مع قبوله لها صحة وجوازا، فلا يستقيم مع ذلك دلي على استحالة قبول الباري تعالى للحوادث.
والأصل الرابع: يشتمل على إيضاح استحالة حوادث لا أول لها، والاعتناء بهذا الركن حتم، فإن إثبات الغرض منه يزعزع جملة مذاهب الملحدة.
فأصل معظمهم أن العالم لم يزل على ما هو عليه. ولم تزل دورة للفلك قبل دورة إلى غير أول.
ثم لم تزل الحوادث في عالم الكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح، فكل ذلك مسبوق بمثله.
وكل ولد مسبوق بوالد وكل زرع مسبوق ببذر، وكل بيضة مسبوقة بدجاجة.
فنقول: موجب أصلكم يقضي بدخول حوادث لا نهاية لأعدادها، ولا غاية لآحادها، على التعاقب في الوجود، وذلك معلوم بطلانه بأوائل العقول، فإنا نفرض القول في الدورة التي نحن فيها.
ونقول: من أصل الملحدة، أنه انقضى قبل الدورة التي نحن فيها دورات لا نهاية لها.
وما انتفت عنه النهاية يستحيل أن يتصرم بالواحد على إثر الواحد.
ص: 31
فإذا انصرمت الدورة التي قبل هذه الدورات أذن انقضاؤها وانتهاؤها بتناهيها، وهذا القدر كافٍ في غرضنا.
فإن قيل : مقام أهل الجنان مؤبد مسر مد، فإذا لم يبعد إثبات حوادث لا آخر لها، لم يبعد إثبات حوادث لا أول لها.
قلنا: المستحيل أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى آحادا على التوالي، وليس في توقع الوجود في الاستقبال والمآل قضاء بوجود ما لا يتناهى، ويستحيل أن يدخل في الوجود من مقدورات الباري تعالى ما لا يحصره عدد ولا يحصيه أمد.
والذي يحقق ذلك أن حقيقة الحادث ما له أول، وإثبات الحوادث مع نفي الأولية تناقض، وليس من حقيقة الحادث أن يكون له آخر.
وضرب المحصلون مثالين في الوجهين فقالوا مثال إثبات حوادث لا أول لها.
قول القائل لمن يخاطبه: لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله دينارًا، ولا أعطيك دينارًا إلا وأعطيك قبله درهما، فلا يتصور أن يعطى على حكم شطره دينارا ولا درهما.
و مثال ما ألزمونا أن يقول القائل : لا أعطيك دينارًا إلا وأعطيك بعده درهما، ولا أعطيك درهما إلا وأعطيك بعده دينارًا، فيتصور منه أن يجري على حكم الشرط.
ص: 32
فإذا ثبت بما ذكرناه الأعراض وحدوثها، واستحالة تعري الجواهر عنها،
واستنادها إلى أول .
فيخرج من مضمون هذه الأصول أن الجواهر لا تسبقها، وما لا يسبق الحوادث حادث على الاضطرار من غير حاجة إلى نظر واعتبار.
وهذه اللمع كافية في إثبات حدث الجواهر والأعراض، ونحن بعد ذلك نوضح الطريق الموصل إلى العلم بالصانع، وبالله التوفيق.
إذا ثبت حدث العالم، وتبين أنه مفتتح الوجود، فالحادث جائز وجوده وانتفاؤه، وكل وقت صادفه وقوعه كان من المجوزات تقدمه عليه بأوقات.
ومن الممكنات استئخار وجوده عن وقته بساعات. فإذا وقع الوجود الجائز بدلا عن استمرار العدم المجوز، قضت العقول ببداهتها بافتقاره إلى مخصص خصصه بالوقوع.
وذلك أرشدكم الله مستبين على الضرورة، ولا حاجة فيه إلى سبر العبر والتمسك بسبيل النظر.
ثم إذا وضح افتقار الحادث إلى مخصص على الجملة، فلا يخلو ذلك المخصص من أن يكون موجبا لوقوع الحدوث بمثابة العلة الموجبة معلولها.
وإما أن يكون طبيعة كما صار إليه الطبائعيون، وإما أن يكون فاعلا مختارا.
ص: 33
وباطل أن يكون جاريًا مجرى العلل فإن العلة توجب معلوها على الاقتران فلو قدر المخصص علة لم يخل من أن تكون قديمة أو حادثة، فإن كانت قديمة فيجب أن توجب وجود العالم أزل
وذلك يفضي إلى القول بقدم العالم، وقد أقمنا الأدلة على حدثه، وإن كانت حادثة افتقرت إلى مخصص، ثم يتسلسل القول في مقتضى المقتضي.
ومن زعم أن المخصص طبيعة ، فقد أحال فيما قال. فإن الطبيعة عند مثبتها توجب آثارها إذا ارتفعت الموانع.
فإن كانت الطبيعة قديمة، فلتقض بقدم العالم.
وإن كانت حادثة، فلتكن مفتقرة إلى مخصص، وهذا القدر كاف في الرد على هؤلاء، ولعلنا نرد على الطبائعيين بعد ذلك إن شاء الله عز وجل.
فإن بطل أن يكون مخصص الحادث علة توجبه أو طبيعة توجده بنفسها لا على الاختيار فيتعين بعد ذلك القطع بأن مخصص الحوادث فاعل لها على الاختيار،
تخصص إيقاعها ببعض الصفات والأوقات.
وإذا أحاط العاقل بحدث العالم واستبان أن له صانعا، فيتعين عليه بعد ذلك النظر في ثلاثة أصول.
يحتوي أحدها على ذكر ما يجب الله تعالى من الصفات.
ص: 34
والثاني: يشتمل على ذكر ما يستحيل عليه.
والثالث: ينطوي على ذكر ما يجوز من أحكامه، وتنصرم بذكر هذه الأصول قواعد العقائد إن شاء الله .
اعلم أن صفاته سبحانه؛ منها نفسية، و منها معنوية. و حقيقة صفة النفس، كل صفة إثبات لنفس، لازمة ما بقيت النفس، غير معللة بعلل قائمة بالموصوف.
و الصفات المعنوية: هي الأحكام الثابتة للموصوف بها، معللة بعلل قائمة بالموصوف.
و تبيين القسمين بالمثال أن كون الجوهر متحيزا هو: صفة إثبات لازمة للجوهر ما استمرت نفسه، و هي غير معللة بزائد على الجوهر، فكانت من صفات النفس؛ و كون العالم عالما، معلل بالعلم القائم بالعالم، فكانت هذه الصفة و ما يضاهيها في غرضنا من الصفات المعنوية.
و سبيلنا أن نتعرض في هذا المعتقد لإثبات العلم بالصفات النفسية الثابتة للباري تعالى، و نفتتحها بالنظر في ثبوت وجوده.
ص: 35
فإن قال قائل: قد دللتم فيما قدمتم على العلم بالصانع، فبم تنكرون على من يقدر الصانع عدما؟
قلنا: العدم عندنا نفي محض و ليس المعدوم على صفة من صفات الإثبات، و لا فرق بين صانع منفي، و بين تقدير الصانع منفيا من كل وجه؛ بل نفي الصانع و إن كان باطلا بالدليل القاطع، فالقول به متناقض في نفسه، و المصير إلى إثبات صانع منفي متناقض. و إنما يلزم القول بالصانع المعدوم المعتزلة، من حيث أثبتوا للمعدوم صفات الإثبات، و قضوا بأن المعدوم على خصائص الأجناس.
و الوجه المرضي أن لا يعد الوجود من الصفات، فإن الوجود نفس الذات، و ليس بمثابة التحيز للجوهر، فإن التحيز صفة زائدة على ذات الجوهر، و وجود الجوهر عندنا نفسه من غير تقدير مزيد.
و الأئمة رضي اللّه عنهم متوسعون في عد الوجود من الصفات، و العلم به علم بالذات.
فإن قيل: ما الدليل على قدم الباري تعالى بعد ثبوت العلم بوجوده، و ما حقيقة القدم أولا؟
قلنا: ذهب بعض الأئمة إلى أن القديم هو الذي لا أول لوجوده.
ص: 36
و قال شيخنا رحمة اللّه عليه: كل موجود استمر وجوده و تقادم زمنا متطاولا، فإنه يسمى قديما في إطلاق اللسان، قال اللّه تعالى: حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [سورة يس: 39].
و غرضنا نصيب الدليل على أن وجود القديم غير مفتتح، و الدليل عليه أنه لو كان حادثا لا فتقر إلى محدث، و كذلك القول في محدثه، و ينساق ذلك إلى إثبات حوادث لا أول لها، و قد سبق إيضاح بطلان ذلك.
فإن قيل: في إثبات موجود لا أول له إثبات أوقات متعاقبة لا نهاية لها، إذ لا يعقل استمرار وجود إلا في أوقات، و ذلك يؤدي إلى إثبات حوادث لا أول لها؛ قلنا: هذا زلل ممن ظنه، فإن الأوقات يعبر بها عن موجودات تقارن موجودا، و كل موجود أضيف إلى مقارنة موجود به فهو وقته، و المستمر في العادات التعبير بالأوقات عن حركات الفلك، و تعاقب الجديدين.
فإذا تبين ذلك في معنى الوقت، فليس من شرط وجود الشي ء أن يقارنه موجود آخر، إذا لم بتعلق أحدهما بالثاني في قضية عقلية، و لو افتقر كل موجود إلى وقت، و قدرت الأوقات موجودة، لافتقرت إلى أوقات،
ص: 37
و ذلك يجر إلى جهالات لا ينتحلها عاقل، و الباري سبحانه قبل حدوث الحوادث منفرد بوجوده و صفاته، لا يقارنه حادث.
الباري سبحانه و تعالى قائم بنفسه، متعال عن الافتقار إلى محل يحله أو مكان يقله. و اختلفت عبارات الأئمة رحمهم اللّه تعالى، في معنى القائم بالنفس؛ فمنهم من قال: هو الموجود المستغني عن المحل، و الجوهر على ذلك قائم بنفسه؛ و قال الأستاذ الإمام أبو إسحاق رحمه اللّه (1): القائم بالنفس هو الموجود المستغني عن المحل و المخصص؛ و ذلك يختص عنده بالباري تعالى، إذ الجوهر، و إن لم يفتقر إلى محل يحله، فقد افتقر وجوده ابتداء إلى مخصص قادر.
و الغرض المعنيّ من هذا الفصل، هو إقامة الدليل على تقدس الرب تبارك و تعالى عن الحاجة إلى محل.
ص: 38
و الدليل عليه أنه لو حل محلا، و افتقر وجوده إليه، لكان المحل قديما و لكان هو صفة له، إذ كل محل موصوف بما قام به، و الصفة يستحيل أن تتصف بالأحكام التي توجبها المعاني.
و سنبين وجوب اتصاف الباري بكونه حيا عالما قادرا.
من صفات نفس القديم تعالى مخالفته للحوادث، فالرب تعالى لا يشبه شيئا من الحوادث، و لا يشبهه شي ء منها.
و لا بد في صدر هذا الفصل من التنبيه على حقيقة المثلين و الخلافين. فالمثلان كل موجودين سدّ أحدهما مسدّ الآخر، و ربما قيل في أحدهما: هما الموجودان اللذان يستويان فيما يجب و يجوز و يستحيل، و الأولى العبارة الأولى. و المختلفان كل موجودين ثبت لأحدهما من صفات النفس ما لم يثبت للثاني.
ص: 39
و ذهب ابن الجبائي (1) و متأخرو المعتزلة إلى أن المثلين هما الشيئان المشتركان في أخص الصفات. ثم قالوا: الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك فيما عداه من الصفات غير المعللة؛
و على هذا المذهب بنوا كثيرا من الأهواء، و هو باطل. فإن الأخص لو أوجب الاشتراك فيه الاشتراك في سائر الصفات النفسية، لامتنع مشاركة الشي ء خلافه في صفات العموم، إذ هما غير مشتركين في الأخص، فإذا فقدت العلة لزم انتفاء المعلول. و قد علمنا أن السواد المخالف للحركة بالأخص مشارك لها في الحدث و الوجود و العرضية و غيرها، فيبطل تعليل التماثل في الصفات بالاشتراك في الأخص. و مما يبطل ذلك، أن الشي ء عندهم يماثل مثله بما يخالف به خلافه. ثم العلم مخالف للقدرة في كونه علما على الضرورة، و منكر ذلك جاحد لها، و ذلك يبطل المصير إلى أن المخالفة و المماثلة تقعان بالأخص.
فالوجه بعد بطلان اعتبار الأخص تعليلا به، أن نقول: لابد من رعاية جمع صفات النفس في تبيين المماثلة،
ص: 40
و قد بطل التعليل بشي ء منها، فلا وجه إلا ذكر جميعها. و قد نقضت المعتزلة أصلها، حيث أثبتوا للباري سبحانه و تعالى إرادة حادثة، يستحيل عليها القيام بالمحال، و قضوا بأنها مثل لإرادتنا القائمة بالمحل، و هذا اعتراف بالاشتراك في الأخص من غير وجوب الاشتراك في سائر الصفات.
فإن قيل: هل يجوز أن يستبد أحد المثلين بحكم عن مماثله؟ أم هل يجوز أن يشارك أحد الخلافين في حكم ما يخالفه؟ قلنا: هذا السؤال يشتمل على مسألتين.
فأما الأولى، فالجواب عنها أن الشي ء لا يستبد بصفة نفس عن مثله، و يجوز أن ينفرد بصفة معنى وقوعا يجوز مثلها على مماثله.
و بيان ذلك بالمثال أن الجواهر متماثلة لاستوائها في صفات الأنفس، إذ لا يستبدّ جوهر عن جوهر بالتميز و قبول الأعراض، إلى غير ذلك من صفات الأنفس، و قد يختص بعض الجواهر بضروب من الأعراض يجوز أمثالها في سائر الجواهر. فخرج من ذلك أن اختصاص الشي ء ببعض الصفات الجائزة على
ص: 41
مماثله لا يقدح في مماثلته له، فإن الشي ء يماثل ما يماثله لنفسه، فيراعى في حكم المماثلة صفات الأنفس. فالطواري الجائزة لا تحيل صفات الأنفس.
و أما المسألة الثانية التي تضمنها السؤال، فالوجه فيها أن لا يمتنع مشاركة الشي ء لما يخالفه في بعض صفات العموم؛ فالسواد و إن خالف البياض فإنه يشاركه في الوجود، و كونهما عرضين لونين، إلى غير ذلك.
و غرضنا من التعرض لهذه المسألة الرد على طوائف من الباطنية «1»، حيث قالوا: لا يثبت للباري، تعالى عن قولهم، صفة من صفات الإثبات. و زعموا أنهم لو وصفوا القديم بكونه موجودا ذاتا، لكان ذلك تشبيها منهم له بالحوادث، إذ هي ذوات موجودات. و سلكوا مسلك النفي فيما يسألون عنه من صفات الإثبات. فإذا قيل لهم الصانع موجود، أبوا ذلك، و قالوا: إنه ليس بمعدوم.
و هذا الذي قالوه لا تحقيق له. فإنا نقول: باضطراد نعلم أنه ليس بين الانتفاء و الثبوت درجة؛ و هؤلاء إن نفوا الصانع أقيمت عليهم الدلائل في إثبات العلم به، و إن أثبتوه لزمهم من إثباته ما حاذروه، إذا الحوادث ثابتة تتضمن إثباته. فإن زعموا أن الصانع ثابت و لكن لا نسميه ثابتا، لم يغنهم ذلك؛
ص: 42
فإن التماثل و الاختلاف يتعلقان بما يثبت عقلا، دون ما يطلق في اللغات و التسميات ثم يلزمهم أن يصفوا الرب تعالى بالوجود، و يمتنعوا من وصف الحوادث به، ففي ذلك حصول غرضهم؛ فبطل ما قالوه من كل وجه.
فإن قيل: فهل تطلقون القول بأن اللّه تعالى يماثل الحوادث في الوجود، أم تأبون ذلك؟ قلنا:
هذا ما لا سبيل إلى إطلاقه؛ فإن القائل إذا قال الرب تعالى يماثل الحوادث، فقد وصف ذاته بالمماثلة، و إنما يشارك القديم الحادث في حكم واحد، فلا وجه لإطلاق التشبيه و التمثيل عموما، ثم رده إلى خصوص، بل الوجه أن يقال: حقيقة الوجود تثبت على وجه واحد شاهدا و غائبا، فيقع التعرض لما فيه الاشتراك دون ما عداه.
فإن قيل: أ لستم تطلقون كونه مخالفا لخلقه، و إن كان مشاركا للحوادث في الوجود؟ قلنا:
المخالفة بين الخلافين لا تجري مجرى المماثلة؛ فإن المماثلة من حقيقتها تساوي المثلين الموصوفين بها في جميع صفات النفس، و المخالفة لا تقتضي الاختلاف في جميع الصفات؛ إذ لا تتحقق المخالفة إلا بين موجودين، فمن ضرورة إطلاق المخالفة التعرض لاشتراك المختلفين في الوجود.
ص: 43
فلما اقتضت المماثلة تعميم الاشتراك في صفات النفس لم نطلقها، و الاختلاف ليس من موضوعه التباين في كل الصفات.
فإن قال قائل: قد ذكرتم أنه لا يمتنع اشتراك القديم و الحادث في بعض صفات الإثبات، ففصّلوا ما يختص بالحوادث من الصفات، و هي تستحيل في حكم الإله. قلنا: نذكر أولا ما يختص الجواهر به. فمما تختص الجواهر به التحيز، و مذهب أهل الحق قاطبة أن اللّه سبحانه و تعالى يتعالى عن التحيز و التخصص بالجهات.
و ذهبت الكرّامية «1» و بعض الحشوية «2» إلى أن الباري، تعالى عن قولهم، متحيز مختص بجهة فوق، تعالى اللّه عن قولهم. و من الدليل على فساد ما انتحلوه أن المختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الأجسام، و كل ما حازى الأجسام لم يخل من أن يكون مساويا لأقدارها، أو لأقدار بعضها، أو يحازيها منه بعضه، و كل أصل قاد إلى تقدير الإله أو تبعيضه فهو كفر صراح.
ص: 44
ثم ما يحازي الأجرام يجوز أن يماسها، و ما جاز عليه مماسة الأجسام و مباينتها كان حادثا، إذ سبيل الدليل على حدث الجواهر قبولها للمماسة و المباينة على ما سبق. فإن طردوا دليل حدث الجواهر، لزم القضاء بحدث ما أثبتوا متحيزا؛ و إن نقضوا الدليل فيما ألزموه، انحسم الطريق إلى إثبات حدث الجواهر.
فإن استدلوا بظاهر قوله تعالى: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى [سورة طه: 5]، فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلها، منها قوله تعالى: وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ [سورة الحديد: 4]، و قوله تعالى: أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ [سورة الرعد: 33]. فنسائلهم عن معنى ذلك؛ فإن حملوه على كونه معنى بالإحاطة و العلم، لم يمتنع منا حمل الاستواء على القهر و الغلبة، و ذلك شائع في اللغة، إذ العرب تقول استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك و استعلى على الرقاب. و فائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم المخلوقات في ظن البرية، فنص تعالى عليه تنبيها بذكره على ما دونه.
فإن قيل: الاستواء بمعنى الغلبة ينبئ عن سبق مكافحة و محاولة، قلنا: هذا باطل، إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر.
ص: 45
ثم الاستواء بمعنى الاستقرار بالذات ينبئ عن اضطراب و اعوجاج سابق، و التزام ذلك كفر. و لا يبعد حمل الاستواء على قصد الإله إلى أمر في العرش، و هذا تأويل سفيان الثّوري رحمه اللّه و استشهد عليه بقوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ [سورة فصلت: 11]، معناه قصد إليها.
فإن قيل: هلا أجريتم الآية على ظاهرها من غير تعرض للتأويل، مصيرا إلى أنها من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا اللّه، قلنا: إن رام السائل إجراء الاستواء على ما ينبئ عنه في ظاهر اللسان، و هو الاستقرار، فهو التزام للتجسيم؛ و إن تشكك في ذلك كان في حكم المصمم على اعتقاد التجسيم، و إن قطع باستحالة الاستقرار، فقد زال الظاهر، و الذي دعا إليه من إجراء الآية على ظاهرها لم يستقم له، و إذا أزيل الظاهر قطعا فلا بد بعده في حمل الآية على محمل مستقيم في العقول مستقر في موجب الشرع. و الإعراض عن التأويل حذرا من مواقعة محذور في الاعتقاد يجر إلى اللبس و الإيهام، و استزلال العوام، و تطريق الشبهات إلى أصول الدين، و تعريض بعض كتاب اللّه تعالى لرجم الظنون. و المعنيّ بقوله تعالى: وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ [سورة آل عمران: 7] الآية.
مراجعة منكري البعث لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في استعجال الساعة، و السؤال عن منتهاها و موقعها و مرساها.
ص: 46
و المراد بقوله تعالى: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [سورة آل عمران: 7]، أي و ما يعلم مآله إلا اللّه، و يشهد لذلك قوله تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ [سورة الأعراف: 53]، و التأويل فيها يحمل على الساعة في اتفاق الجماعة.
صرحت طوائف من الكرّامية بتسمية الرب تعالى عن قولهم جسما، و سبيل مفاتحتهم بالكلام أن نقول: الجسم هو المؤلف، في حقيقة اللغة، و لذلك يقال في شخص فضل شخصا بالعبالة و كثرة تآلف الأجزاء إنه أجسم منه و إنه جسيم، و لا وجه لحمل المبالغة إلا على تآلف الأجزاء. فإذا أنبأتنا المبالغة المأخوذة من الجسم على زيادة التأليف، فاسم الجسم يجب أن يدل على أصل التأليف؛ إذ الأعلم لمّا دل على مزية في العلم، دل العالم على أصله.
ثم نقول: إن سميتم الباري تعالى جسما و أثبتم له حقائق الأجسام، فقد تعرضتم لأمرين: إما نقض دلالة حدث الجواهر، فإن مبناها على قبولها للتأليف و المماسة و المباينة؛ و إما أن تطردوها و تقضوا بقيام دلالة الحدث في وجود الصانع.
ص: 47
و كلاهما خروج عن الدين، و انسلال عن ربقة المسلمين.
و من زعم منهم أنه لا يثبت للباري تعالى أحكام الأجسام، و إنما المعنى بتسميته جسما الدلالة على وجوده؛ فإن قالوا ذلك قيل لهم: لم تحكمتم بتسمية ربكم باسم ينبئ عما يستحيل في صفته، من غير أن يرد به شرع أو يستقر فيه سمع، و ما الفصل بينكم و بين من يسميه جسدا، ثم يحمل الجسد على الوجود؟ فإن قيل: إذا لم يمتنع تسمية الإله نفسا، كما دل عليه قوله تعالى: تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ [سورة المائدة: 116]، فلا يمتنع أيضا تسميته جسما؛ قلنا: لا يسوغ القياس في إثبات أسماء الرب سبحانه و تعالى، إذ لو ساغ ذلك لساغ مثله في الجسد. على أن النفس يراد بها الوجود؛ و لذلك يحسن قول القائل: نفس العرض و العرض نفسه، و لا يصح أن يقال: جسم العرض، ثم الأصل اتباع الشرع.
مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله قبول الأعراض و صحة الاتصاف بالحوادث، و الرب سبحانه و تعالى يتقدس عن قبول الحوادث. و ذهبت الكرّامية إلى أن الحوادث تقوم بذات الرب تعالى عن قولهم؛ ثم زعموا أنه لا يتصف بما يقوم به من الحوادث، و صار إلى جهالة لم يسبقوا إليها،
ص: 48
فقالوا: القول الحادث يقوم بذات الرب سبحانه و تعالى، و هو غير قائل به، و إنما هو قائل بالقائلية.
و حقيقة أصلهم أن أسماء الرب لا يجوز أن تتجدد، و لذلك و صفوه بكونه خالقا في الأزل، و لم يتحاشوا من قيام الحوادث به، و تنكبوا عن إثبات وصف جديد له ذكرا و قولا.
و الدليل على بطلان ما قالوه، أنه لو قبل الحوادث لم يخل منها، لما سبق تقريره في الجواهر، حيث قضينا باستحالة تعرّيها عن الأعراض، و ما لم يخل من الحوادث لم يسبقها، و ينساق ذلك إلى الحكم بحدث الصانع.
و لا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض، على تفصيل لهم أشرنا إليه، و إثباتهم أحكاما متجددة لذات الباري تعالى من الإرادات الحادثة القائمة، لا بمحال على زعمهم. و يصدهم أيضا عن طرد دليلهم في هذه المسألة، أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام للذات من غير أن تدل على الحدث، لم يبعد مثل ذلك في اعتوار أنفس الأعراض على الذات.
و نقول للكرّامية: مصيركم إلى إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف الباري به تناقض، إذ لو جاز قيام معنى بمحل غائبا من غير أن يتصف بحكمه، لجاز شاهدا قيام أقوال و علوم و إرادات بمحال من غير أن تتصف المحال بأحكام موجبة عن المعاني،
ص: 49
و ذلك يخلط الحقائق و يجر إلى جهالات. ثم نقول لهم: إذا جوزتم قيام ضروب من الحوادث بذاته، فما المانع من تجويز قيام ألوان حادثة بذاته على التعاقب، و كذلك سبيل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به سبحانه من الحوادث، و مما يلزمهم تجويز قيام قدرة حادثة و علم حادث بذاته، على حسب أصلهم في القول و الإرادة الحادثتين، و لا يجدون بين ما جوزوه و امتنعوا منه فصلا.
و نقول أيضا: إذا وصفتم الرب تعالى بكونه متحيزا، و كل متحيز حجم و جرم، فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الألوان، فما المانع من تجويز قيام الألوان بذات الرب. و لا محيص لهم عن شي ء مما ألزموه.
الجوهر في اصطلاح المتكلمين هو المتحيز، و قد أوضحنا الدليل على استحالة كون الباري تعالى متحيزا.
ص: 50
و قد يحد الجوهر بالقابل للأعراض، و قد تبين استحالة قبول الباري سبحانه و تعالى للحوادث. و من وصف الباري تعالى بكونه جوهرا، قسم الكلام عليه، و قيل له: إن أردت بتسميته جوهرا اتصافه بخصائص الجواهر، فقد سبقت الأدلة على استحالة ذلك عليه. و إن أردت التسمية من غير وصفه بحقيقته و خاصيته، فالتسميتان تتلقى من السمع؛ إذ العقول لا تدل عليها، و ليس يشهد لهذه التسمية دلالة سمعية، و لا يسوغ في شي ء من الملل التحكم بتسمية الباري تلقينا.
و ذهبت النصارى إلى أن الباري، سبحانه و تعالى عن قولهم، جوهر، و أنه ثالث ثلاثة، و عنوا بكونه جوهرا أنه أصل للأقانيم. و الأقانيم عندهم ثلاثة: الوجود، و الحياة، و العلم. ثم يعبرون عن الوجود بالأب، و عن العلم بالكلمة، و قد يسمونه ابنا، و يعبرون عن الحياة بروح القدس. و لا يعنون بالكلمة الكلام، فإن الكلام مخلوق عندهم.
ثم هذه الأقانيم هي الجوهر عندهم بلا مزيد، و الجوهر واحد و الأقانيم ثلاثة، و ليست الأقانيم عندهم موجودات بأنفسها، بل هي للجوهر في حكم الأحوال عند مثبتيها من الإسلاميين. و الحال مثل التحيز للجوهر، و هو حال زائدة على وجود الجوهر.
ص: 51
و لا تتصف الحال بالعدم و لا بالوجود، و لكنها صفة وجود، و الأقانيم حالة محل الأحوال عند النصارى.
ثم زعموا أن الكلمة اتحدت بالمسيح، و تدرعت بالناسوت منه، و اختلفت مذاهبهم في تدرع اللاهوت بالناسوت؛ فزعم بعضهم أن المعنى به حلول الكلمة جسد المسيح، كما يحل العرض محله؛ و ذهبت الروم إلى أن الكلمة مازجت جسد المسيح، و خالطته مخالطة الخمر اللبن.
فهذه أصول مذاهبهم، فنقول لهم: لا معنى لحصركم الأقانيم فيما ذكرتموه، و بم تنكرون على من يرغم أن الأقانيم أربعة، منها القدرة، فليس إخراج القدرة من الأقانيم أولى من إخراج العلم. و كذلك إن ساغ المصير إلى أن الوجود أقنوم، فلا يمتنع عدّ البقاء أقنوما، و يلزمون السمع و البصر على نحو ما تقدم.
و نقول لهم: إذا زعمتم أن الكلمة تتدرع بالمسيح، و فسرتموه بالحلول، قيل لكم: العلم المسمى كلمة، هل يفارق الجوهر أم لا، فإن زعموا أنه يفارقه، لزمهم فيه أن يقولوا: لم يكن للجوهر أقنوم العلم لما كان العلم متدرعا بالمسيح، و هذا مما يأبونه.
ص: 52
فإن زعموا أن أقنوم العلم لم يفارق الجوهر، استحال مع ذلك حلوله في جسد المسيح عيسى عليه السلام مع اختصاصه بالجوهر الأول، فإنه يمتنع حلول عرض في جسم مع بقاء ذلك العرض في جسم آخر؛ فإذا امتنع ذلك في العرض، فلأن يمتنع ذلك في الخاصية التي تتنزل منزلة صفات النفس أولى. و لو جاز أن تتحد الكلمة بالمسيح، لجاز أن يتحد الجوهر بالناسوت، و لا فصل في ذلك، و قد منعوا اتحاد الجوهر بالناسوت.
و يقال لهم: إذا اتحدت الكلمة بالمسيح، فهلا اتحد به روح القدس، و هو أقنوم الحياة، فإن من حكم العلم أن لا يفارق الحياة؟ و كل ذلك يوضح خبط النصارى.
و الرد على الروم في الاختلاط بمثابة الرد على أصحاب الحلول؛ و يخصصون بأن الاختلاط إنما يتصف به الأجرام و الأجسام، فكيف وجهه في الأقنوم الذي هو خاصية!
و مما يصعب موقعه عليهم أن نقول: بم تنكرون على من يزعم أن الكلمة اتحدت بموسى صلوات اللّه عليه، و لذلك كان يقلب العصا ثعبانا مبينا، و يفلق البحر أفلاقا، كالأطواد، إلى غير ذلك من آياته عليه السلام؟
و الذي انتحلوا فاسد معتقدهم من أجله، ما ظهر على يد عيسى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من إبراء الأكمه و الأبرص و إحياء الموتى بإذن اللّه. فإذا عورضوا
ص: 53
بآيات غيره من الأنبياء عليهم السلام، اضطربت مذاهبهم، و لم يرجعوا إلى محصول، إذ أصلهم أن الاتحاد لم يقع إلا بالمسيح عليه السلام.
ثم مذهبهم أن الأقانيم آلهة، و النصارى مع اختلاف فرقها مجتمعون على التثليث؛ فنقول لهم: كل أقنوم لا يتصف عندكم بالوجود على حياله، فكيف يتصف بالإلهية ما لا يتصف بالوجود؟
و سنقيم واضح الأدلة على أن الإله يجب أن يكون حيا عالما قادرا، فلو كان أقنوم العلم إلها لوجب أن يكون حيا قادرا. ثم يقال لهم: هلا جعلتم الآلهة أربعة: الجوهر، و الوجود، و الحياة، و العلم؟ لو لا الركون إلى محض التحكم في الدين!.
ثم أطبقت النصارى على أن المسيح إله، و أطبقوا على أنه ابن، و اتفقوا على أنه لاهوت و ناسوت، و هذه مناقضات؛ فإن إطلاق اسم الإله يمحض حكم الإلهية، و ليس المسيح إلها محضا.
ثم أطبقوا على أن المسيح صلب، و لما روجعوا قالوا: المصلوب الناسوت، و الناسوت المحض ليس هو المسيح. و نعتضد الرد عليهم بإثبات الوحدانية، و فيما قلناه أكمل مقنع.
ص: 54
الباري سبحانه و تعالى واحد، و الواحد في اصطلاح الأصوليين الشي ء الذي لا ينقسم، و لو قيل الواحد هو الشي ء لوقع الاكتفاء بذلك. و الرب سبحانه و تعالى موجود فرد، متقدس عن قبول التبعيض و الانقسام. و قد يراد بتسميته واحدا أنه لا مثل له و لا نظير. و يترتب على اعتقاد حقيقة الوحدانية. إيضاح الدليل على أن الإله ليس بمؤلف؛ إذ لو كان كذلك، تعالى اللّه عنه و تقدس، لكان كل بعض قائما بنفسه عالما حيا قادرا، و ذلك تصريح بإثبات إلهين.
و الغرض من ذلك يبتنى على أن حكم العلم يختص بما قام به، و كذلك القول في جملة المعاني الموجبة أحكامها لما قامت به. و لو قدر بعضين، و حكم بقيام العلم و القدرة و الحياة بأحدهما، فهو الإله، و الزائد عليه قديم على هذا التقدير غير متصف بأوصاف الألوهية، و ذلك ما نوضح بطلانه في آخر هذا الباب. فإذا، اتضح المراد من حقيقة الوحدانية على الجملة.
فالمقصود من عقد هذا الباب إيضاح الدليل على أن الإله واحد و يستحيل تقدير إلهين.
ص: 55
فالمقصود من عقد هذا الباب إيضاح الدليل على أن الإله واحد و يستحيل تقدير إلهين.
و الدليل عليه، أنّا لو قدرنا إلهين، و فرضنا الكلام في جسم و قدرنا من أحدهما إرادة تحريكه و من الثاني إرادة تسكينه، فتتصدى لنا وجوه كلها مستحيلة. و ذلك أنّا لو فرضنا نفوذ إرادتيهما و وقع مراديهما، لأفضى ذلك إلى اجتماع الحركة و السكون في المحل الواحد، و الدلالة منصوبة على اتحاد الوقت و المحل. و يستحيل أيضا أن لا تنفذ إرادتيهما، فإن ذلك يؤدي إلى خلو المحل القابل للحركة و السكون عنهما، ثم مآله إثبات إلهين عاجزين قاصرين عن تنفيذ المراد. و يستحيل أيضا الحكم بنفوذ إرادة أحدهما دون الثاني، إذ في ذلك تعجيز من لم تنفذ إرادته، و سندل على استحالة ثبوت قديم عاجز.
فإن قيل: رتبتم هذه الدلالة على اختلاف إرادتي القديمين، فبم تنكرون على من يعتقد قديمين يريد كل واحد منهما ما يريده الآخر؟ قلنا هذه الدلالة تطرد على تقدير الاختلاف كما قررناه، و هي مطردة أيضا على تقدير الاتفاق؛ فإن إرادة تحريك الجسم من أحدهما مع إرادة الثاني تسكينه ممكنة غير مستحيلة، و كل ما دل وقوعه على العجز و الاتصاف ببعض القصور دل جوازه على مثله.
و الدليل عليه أن من اعتقد جواز قيام الحوادث بالقديم، ملتزما ما يفضي إلى الحكم بحدثه، نازل منزلة من يعتقد قيام الحوادث به وقوعا و تحققا.
ص: 56
و الجاري من أحد المحدثين في تنفيذ إرادته المتصدي لأن يمنع عرضة للنقص، كالمصدود عما يريده حقا بتسوية بين من يجوز ضده و بين من اتفق رده.
فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن اختلاف القديمين في الإرادة غير جائز و لا واقع؟ قلنا:
لو قدرنا انفراد أحدهما لما امتنع في قضية العقل إرادته تحريك الجسم في الوقت المفروض، و لو قدرنا انفراد الثاني لم تمتنع إرادته تسكينه. و لا توجب ذات لا اختصاص لها بأخرى تغيير أحكام صفاتهما؛ فليجز من كل واحد منهما عند تقدير الاجتماع، ما يجوز عند تقدير الانفراد.
و قال بعض الحذاق: غايتنا في دلالة التمانع، امتناع وقوع مرادين؛ و إثبات قديمين على قضية هذا السؤال يفضي إلى منع، ما يجوز لكل قديم لو قدرنا انفراده، و ذلك أحق بالدلالة على التعجيز و التنقيص.
و لا تستمر هذه الدلالة على أصول المعتزلة، مع مصيرهم إلى أنه يقع من العباد ما لا يريده الرب، تعالى عن قولهم، و لا يتضمن ذلك عندهم الحكم بقصوره. فإن قالوا: الرب تعالى قادر على إلجاء الخلق إلى ما يريده، قيل: مراده عندكم أن يؤمن العباد على الاختيار إيمانا مثابا عليه، و لا يريد منهم إيمانا و هم إليه ملجئون و عليه مكرهون؛ فالذي يريده لا يقدر على إيقاعه، و الذي يقدر عليه لا يريده.
ص: 57
قيل مراده عندكم أن يؤمن العباد على الاختيار إيمانا مثابا عليه، ولا يريد إيمانا وهم إليه ملجئون وعليه مكرهون؛ فالذي يريده لا يقدر على إيقاعه، والذي يقدر عليه لا يريده.
و قد أضرب شيوخ المعتزلة عن دلالة التمانع لما ذكرناه، و هي المنصوصة في نص قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [سورة الأنبياء: 22].
فإن قيل: قد أسندتم الدليل على الوحدانية إلى استحالة ثبوت قديم عاجز، و أنتم بالدليل على ذلك مطالبون؛ قلنا: لو قدرنا قديما عاجزا، لكان عاجزا بعجز قديم قائم به، و العقل يقضي باستحالة العجز القديم، لأن من حكم العجز أن يمتنع به إيقاع الفعل الممكن في نفسه. و لو أثبتنا عجزا قديما، لجرّنا ذلك إلى الحكم بإمكان الفعل أزلا، ثم القضاء بأن العجز مانع منه، و باضطرار نعلم استحالة الفعل أزلا، و هذا بمثابة قطعنا باستحالة تقدير حركة قديمة؛ إذ الحركة لا بد أن تكون مسبوقة بكون في مكان، ثم تكون الحركة انتقالا منه.
فإن قيل: ما ذكرتموه ينعكس عليكم في إثبات القدرة القديمة؛ إذ القدرة القديمة تقتضي تمكنا من الفعل، فالتزموا من إثبات القدرة الأزلية الحكم بإمكان فعل أزلي؛
ص: 58
قلنا: ليس من حكم القدرة التمكن بها ناجزا، إذ لو قدرنا شاهدا قدرة باقية، و اعتقدنا ذلك مثلا، فلا يمتنع تقدمها على المقدور، و لا يمتنع منع القادر عن مقدوره مع استمرار قدرته؛ فوضح بذلك أنا لا نشترط مقارنة إمكان وقوع المقدور للقدرة، و يستحيل من كل وجه التمكن من الفعل مع العجز عنه.
فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن مقدورات القديم متناهية، و الكلام في إثبات الوحدانية يتشبث بنفي النهاية عن مقدورات الإله؟ قلنا: إن خصص السائل السؤال بتقدير قديم واحد، فالجواب أن المقدورات لو تناهت مع أن العقل يقضي بجواز وقوع أمثال ما وقع، و الجائز وقوعه لا يقع بنفسه من غير مقتض، و في قصر القدرة على ما يتناهى إخراج أمثاله عن إمكان الوقوع، إذ لا يقع حادث إلا بالقدرة، و مساق ذلك يجر إلى جمع الاستحالة و الإمكان فيما علم فيه الإمكان.
و إن فرض السائل السؤال عن قديمين، فزعم أن أحدهما يقدر على قبيل من المقدورات، و الثاني يقدر على قبيل آخر، و هذا من أغمض ما يسأل عنه؛ فنقول: نحن نصور جسما و نتعرض لتقسيم الدليل لتحريكه و تسكينه.
ص: 59
فإن زعم السائل أنهما جميعا خارجان عن مقدوريهما، كان محالا مؤديا إلى خلو الجسم عن الحركة و السكون؛ و إن قدر السكون مقدورا لأحدهما، و الحركة مقدورة للثاني، فمآل هذا التقدير التمانع كما قررناه.
فإن قيل: الحركة و السكون و قبيل الأكوان مقدور أحدهما و ليس مقدورا للثاني، فنفرض الدليل في الألوان. فإن عورضنا فيها تعديناها إلى قبيل آخر من الأعراض، و لا نزال كذلك حتى ينساق الدليل إلى أحد أمرين؛ إما أن يشتركا في الاقتدار على قبيل من الأعراض، و يترتب عليه التمانع، إذ كل قبيل من الأعراض يشتمل على المتضادات. و إن عورضنا فرضنا الدليل في المثلين من كل قبيل ليستقر فيه الدليل، فإن المثلين يتضادان، كما سنذكر في درج الكلام إن شاء اللّه عزّ و جلّ؛ فهذا أحد مآلي الممانعة التي قدرناها.
و لو قال السائل: إن أحد القديمين ينفرد بالاقتدار على خلق جميع أجناس الأعراض؛ قيل:
هل يتصف الثاني بالاقتدار على خلق الجواهر أم لا؟
ص: 60
فإن قال السائل: إنه لا يقتدر عليه، فقد أخرجه عن كونه قادرا أصلا، و إثبات قديم غير قادر على مقدور و لا عالم بمعلوم و لا حي بحياة تحكم بادعاء ما لا دليل عليه. و ليس غرضنا في هذا المعتقد الدليل على نفيه، و مقصودنا التعرض لنفي قديمين يقدر لكل واحد منهما حكم الإلهية.
على أن القديم واجب وجوده، إذ لو قدر انتفاؤه لما وقع ممكن، إذ الممكن لا يقع بنفسه؛ و في العلم البديهي بجواز وقوع الممكنات ما يقتضي القطع بوجوب وجود القديم، و في الحكم بجوازه انقلاب الواجب جائزا. فلو أثبتنا قديما غير مؤثر، لكان لا يجب وجوده، إذ لا يتعلق بوجوده جواز جائز من الأفعال. فإذا كان جائزا امتنع كونه قديما إذ القديم يجب وجوده، و الجائز يفتقر وقوعه إلى مقتض، و الحكم بالجواز و القدم متناقض.
و إن قال السائل: خلق الجواهر مقدور للذي لم نصفه بالاقتدار على الأعراض؛ فنقول:
الجوهر الفرد العري عن الأعراض غير ممكن، و لا يتعلق الاقتدار إلا بممكن، و حق المقتدر على الاختراع أن يتمكن من إيقاع مقدوره؛ و هذا القدر كاف فافهمه.
ص: 61
و هذه جمل كافية في إثبات العلم بالصفات الواجبة النفسية، و قد ضمّنّاها و أدرجنا فيها ما يستحيل على الباري تعالى، حيث نفينا عنه خصائص الجواهر و الأعراض، و نصبنا الأدلة على تقدسه عن أحكام الأجسام. و ما ذكرناه يغني عن التعرض لكثير مما يرسمه المتكلمون فيما يستحيل على الباري تعالى.
و إذا سئل العاقل عما يستحيل على ربه، فالعبارة الوجيزة في الجواب أن يقول: يستحيل عليه كل ما يدل على حدثه؛ و يندرج تحت ذلك استحالة تميزه، و قبوله للحوادث، و افتقاره إلى محل يحله.
و كل ما ذكرناه أحد قسمي الصفات الواجبة، و هي النفسية منها، فأما المعنوية فها نحن نبتديها.
اعلموا أرشدكم اللّه تعالى أن الكلام في هذا الباب يتشعب، و هو عمدة أهل التوحيد. و غرضنا على مقدار قصدنا ضبط ركنين: أحدهما إثبات العلم بأحكام الصفات، و الثاني إثبات العلم بالصفات الموجبة لأحكامها.
فأما الأحكام، فمما نصدر الباب به أن نوضح كون صانع العالم قادرا عالما،
ص: 62
و لا حاجة بنا بعد سبق المقدمات التي ذكرناها إلى نظر و اعتبار في القطع بكون الصانع عالما قادرا. فإذا تقرر أن الباري تعالى صانع العالم، و استبان للعاقل لطائف الصنع، و أحاط بما تتصف به السموات و الأرض و ما بينهما من الاتساق و الانتظام و الإتقان و الإحكام، فيضطر إلى العلم بأنها لم تحدث إلا من عالم بها قادر عليها، و لا يستريب اللبيب في امتناع الاختراع من الجهلة و الموتى و الجمادات و العجزة.
و كذلك يعلم كل عاقل على البديهة، أن الفعل الرصين المحكم المتين يستحيل صدوره من الجاهل به. و من جوّز، و قد لاحت له سطور منظومة و خطوط متسقة مرقومة، صدورها من جاهل بالخط كان عن المعقول خارجا، و في تيه الجهل والجا.
و قد حاول بعض المتكلمين سبر النظر و طرق العبر في ذلك، و مسلكهم ما نومئ إليه. و ذلك أنهم قالوا: ألفينا الأفعال تمتنع على بعض الموجودات و لا تمتنع على بعضها. ثم إذا نظرنا في الموانع جرّنا السّبر و التقسيم إلى أن الذي لا يمتنع عليه الفعل القادر العالم، و مآل ذلك يستند إلى دعوى الضرورة؛ إذ لو قال قائل: لا يمتنع الفعل على موجود، لكان الوجه في الرد عليه نسبته إلى جحد الضرورة.
ص: 63
فإذا اضطرنا إلى ذلك انتهاء، كان الأحرى أن نتمسك به ابتداء.
فإن قيل: قد أطلق العقلاء القول بدلالة المحكم على علم المحكم، و الذي ذكرتموه خروج على قولهم؛ قلنا: المرضي عندنا في ذلك أن الحادث يدل على القدرة أو على كون القادر قادرا، و المحكم يدل على كون المحكم عالما؛ و لكن يدرك كون ما ذكرناه دليلا ضرورة من غير احتياج إلى مباحثة و نظر يفضي إذا صح إلى العثور على الوجه الذي منه يدل الدليل، فاعلم ذلك.
فإذا اتضح كون الباري سبحانه عالما قادرا، فباضطرار تعلم كونه حيا. و لو نظر العاقل بدءا في الفعل و اعتقد أن له صانعا، فيضطر منه إلى العلم بكون صانعه حيا، إذا درأ عن معتقداته وساوس الطبائعيين، كما سبقت الإشارة إليها. فهذا القدر كاف في هذا المعتقد.
صانع العالم مريد على الحقيقة، و ذهب أبو القاسم الكعبي إلى أن الباري تعالى لا يتصف بكونه مريدا على الحقيقة؛
ص: 64
و إن وصف بذلك شرعا في أفعاله، فالمراد بكونه مريدا لها أنه خالقها و منشئها. و إذا وصف بكونه مريدا لبعض أفعال، فالمراد بوصفه أنه أمر بها. و ذهب النجار (1) إلى أن الباري تعالى مريد لنفسه. ثم قال عند المراجعة: المعنى بكونه مريدا، أنه غير مستكره و لا مغلوب.
و ذهب بعض معتزلة البصرة إلى أن الباري تعالى مريد للحوادث بإرادة حادثة ثابتة لا في محل، و زعموا أن كل حادث من أفعاله مراد له بإرادة حادثة، و كل مأمور به من أفعال العباد مراد له، و لا تتعلق إرادة واحدة بمرادين عندهم، ثم الإرادات تقع حادثة غير مرادة.
و أما وجه الرد على الكعبي و متبعيه، فهو أن نقول: قد سلمتم لنا أن اختصاص أفعال العباد بالوقوع في بعض الأوقات على خصائص من الصفات، يقتضي القصد إلى تخصيصها بأوقاتها و خصائص صفاتها، كما أن الاتساق و الانتظام و الإتقان و الإحكام تدل على كون المتقن عالما، فكذلك الاختصاص يدل على كونه قاصدا إلى التخصيص، و الأدلة العقلية المفضية إلى القطع يلزم اطرادها.
ص: 65
و لو تخيل العاقل ثبوت الدلالة غير دالة، لكان ذلك موجبا لخروجها عن قضية الأدلة على العموم.
فنقول للكعبي، بعد تقرير ذلك: كل وجه يدل العقل شاهدا من أجله على كونه مرادا مقصودا، فهو مقرر في فعل اللّه تعالى بتلازم دلالة فعله على ما دل عليه الفعل شاهدا. و لو ساغ التعرض لنقض الدلالة و عدم طردها، لساغ أن يدل الإحكام شاهدا على كون المحكم عالما، من غير أن يدل الإحكام في فعل اللّه تعالى على كونه عالما.
فإن قيل: إنما يدل الفعل شاهدا على القصد من حيث لا يحيط الفاعل بالمغيب عنه، فإذا لم يتصف بكونه عالما بوقت وقوع الفعل و ما يختص به لم يكن بدّ من تخصيص قصد؛ و الباري تعالى عالم بالغيوب على حقائقها، فوقع الاجتزاء بكونه عالما عن تقدير كونه مريدا.
و هذا باطل من أوجه؛
أقربها أن ما ذكروه يجر عليهم أن يحكموا بأن الباري تعالى غير قادر اكتفاء بكونه عالما، و فرق في ذلك بين الشاهد و الغائب. ثم نفرض عليهم فاعلا شاهدا مطلعا على ما سيكون من فعله، بإنباء صادق أتاه، أو إعلام اللّه إياه.
ص: 66
و لو كان الأمر كذلك لافتقر الفعل مع ذلك إلى القصد إليه، فبطل التعويل على صرف وجه الدليل إلى ذهول الفاعل عما لم يقع من فعله.
ثم الناظر في الأفعال المقدورة للعباد يستدل على قصدهم بأفعالهم، و إن لم يخطر له ذهولهم و انطواء الغيوب عنهم؛ فلو كان الفعل يدل على القصد شاهدا من حيث لم يعلم الفاعل مآل الأفعال، لتوقف الاستدلال للناظر على أن يخطر ذلك بالبال، فإن انخرام ركن من الاستدلال يمنع العثور على العلم في ثاني الحال.
و إن تعسّف من متبعي الكعبي متعسّف، و زعم أن الفعل شاهدا غير دال على قصد الفاعل إليه، و إن ثبت القصد فهو غير مدلول بالفعل؛ فيقال له: هذا جحد للضرورة، و تعرض لالتزام جهالات. و أقرب ما يعارض هذا القائل، أن يقال له: لا يدل المحكم على علم المحكم، و إن ثبت العلم فبدلالة أخرى.
و هذه الطريقة لا تستمر على أصول المعتزلة من البصريين على الكعبي، فإنهم قد نقضوا الدلالة في قواعد من العقائد.
و نحن نورد الآن وجها واحدا منها، و هو أن الإحكام في فعل الباري تعالى دلالة على كونه عالما عندهم، و أثبتوا أفعالا محكمة شاهدا مخترعة للعبد على زعمهم، و هي صادرة منه مع غفلته عنها لذهوله عن معظم صفاتها،
ص: 67
فإذا ساغ لهم نقد دلالة الأحكام لم تستمر لهم مطالبة الكعبي، لما مهدناه من السبيل في لزوم طرد الدليل، و هذا القدر كاف في الرد على الكعبي.
و أما وجه الرد على النجار و أتباعه، فهو أن نقول: قولكم إن الباري سبحانه مريد لنفسه، منقسم عليكم؛ فإن أردتم بذلك كونه مريدا قاصدا على التحقيق، كما نعتّموه بكونه عالما لنفسه، فسيأتي الرد عليكم و على إخوانكم، إذا نجز غرضنا من إثبات العلم بأحكام الصفات.
و لا وجه في الرد عليهم إن سلكوا هذا المسلك، إلا التمسك بالطرق الدالة على العلم، و القدرة، و الحياة.
و قد حاولت المعتزلة طرقا في منع كون الباري تعالى مريدا لنفسه كلها باطلة، و سنشير إلى الغرض منها عند ردنا على البصريين.
فإن زعمت النجارية أن المعنى بكون مريدا لنفسه أنه غير مغلوب و لا مستكره، فيقال لهم: قد فسرتم الإثبات بالنفي، فإن نفي الغلبة و الاستكراه يتضمن إثبات حكم صفة. ثم هم مساعدون على نفي الغلبة و الاستكراه، و مطالبون بعد هذه الموافقة بأن يثبتوا كون الإله قاصدا إلى فعله؛ فإن تمنعوا من ذلك ألزموا ما ألزم الكعبي على ما قدمناه حرفا حرفا، و مآل هذا المذهب يرجع إلى نفي حكم الإرادة.
ص: 68
و قد ألزم النجارية على أصلهم مناقضات. فقيل لهم: إن كان المريد هو الذي لا يغلب و لا يستكره، فليكن الباري مريدا لنفسه من حيث إنه غير مغلوب فيها و لا مستكره عليها.
و أما البصريون، فالكلام عليهم في فصلين: أحدهما في وصفهم الباري تعالى بكونه مريدا، و الثاني في حكمهم بحدوث إرادته.
فنقول أولا: ما دليلكم على كون الباري تعالى مريدا؟ فإن زعموا أن الدليل على ذلك اختصاص الحوادث بأوقاتها و صفاتها، بطل عليهم دليلهم بالإرادات الحادثة التي أثبتوها، و زعموا أنها غير مرادة، فإنها حادثة مختصة بأوقاتها، و هي غير مرادة. فإن قالوا: الإرادة يراد بها و لا تراد هي في نفسها، و ربما يضربون أمثالا يموهون بها؛ و يقولون: بعض المحسوسات يشتهى، و الشهوة لا تشتهى؛ و الأمر المطلوب يتمنى، و التمني لا يتمنى؛ و كذلك الإرادة لا تراد و يراد بها، و هذا الذي ذكروه دعوى عرية عن البرهان؛ فإن من جمع بين مختلف فيه و متفق عليه، احتاج إلى نصب دليل قاطع على وجوب الجمع بينهما، ثم لا يسلم ما قالوه من معارضة تخالفه.
فلو قال قائل: العلم يعلم به و لا يعلم في نفسه، جريا على ما مهدوه، و قياسا على الشهوة و التمني، لكان الكلام عليه كالكلام عليهم.
ص: 69
ثم نقول: من فعل فعلا، و كان عالما بإنشائه إياه في وقت مخصوص، فلا بدّ أن يكون مؤثرا وقوعه في ذلك الوقت مع اقتداره عليه و علمه به، و وضح ذلك يداني مدارك الضرورات.
ثم العقل يقضي باستواء الإرادة الموقعة في وقت و غيرها من الحوادث. فبطل تعويلهم على أن الإرادة لا تراد، ثم لا يغنيهم خبطهم في الإرادة، و قد نقضت دليلهم؛ فإن ما عولوا عليه من دلالة الاختصاص على الإرادة يبطل عليهم بالإرادة، و كلامهم بعد ذلك تعليل للنقض، فقد انسدّ عليهم طريق الاستدلال، على كون الباري تعالى مريدا.
و مما يطالبون به، أن يقال لهم: بم تنكرون على من يزعم أن الباري سبحانه و تعالى مريد لنفسه، كما أن حيّ قادر عالم بنفسه عندكم؟
فإن قالوا: إنما يمتنع ذلك لأن الحكم الثابت للنفس إذا كان يقتضي تعلقا، يجب أن يعم تعلقه جملة المتعلقات، و لذلك وجب كونه عالما بكل معلوم، لما كان عالما لنفسه؛ إذ لا اختصاص للنفس ببعض المتعلقات دون بعض، و مساق ذلك يوجب كونه مريدا لكل مراد لو كان مريدا لنفسه.
و هذا الذي ذكروه من تحكماتهم الباطلة. و يقال لهم: بأي دليل أنكرتم تعلق الحكم النفسي ببعض المتعلقات دون بعض؟ و بم تردون على من يقول من النجّارية: إنه مريد لبعض المرادات لنفسه، و هذا بمثابة اختصاص العلم الحادث يتعلق بمتعلقه لعينه؛
ص: 70
و ليس لقائل أن يقول: لا اختصاص للعلم بالسواد، و إضافته إلى السواد بمثابة إضافته إلى غيره.
فإن قالوا: قد استشهدنا بكونه عالما بكل معلوم، قلنا: تحكمتم في الاستدلال و ضرب الأمثال. فلم زعمتم أنه إنما يجب كون الباري تعالى عالما بكل معلوم من حيث كان عالما لنفسه؟
و قد علمتم أن مذهب خصومكم اعتقاد ثبوت الصفات، و المصير إلى أن الباري تعالى عالم بعلم. ثم ما ذكروه تولوا نقضه حينما قالوا: الباري قادر لنفسه، و لا يتصف بكونه قادرا على كل مقدور، فإن مقدورات العباد غير مقدورات له. و قد أثبت المتأخرون منهم أجناسا مقدورة للعباد، و منعوا كونها مقدورة للرب تعالى، سواء كانت مقدورة للعبد أم لم تخلق له القدرة عليها، منها الجهل.
فإن قالوا: مقدورات العباد لم تتعلق بها قدرة القديم، من حيث استحال مقدور بين قادرين، و المستحيل لا يعد من قبيل المقدورات؛ قلنا: لا ينجيكم روغانكم عما ألزمتموه؛ فإن ما سيقدر عليه عبد في معلوم اللّه تعالى غير مقدور للّه تعالى قبل أن يقدر عليه عبده عندكم، و هو إذ ذاك غير مقدور للعبد. و لا يحتمل هذا المعتقد أكثر مما ذكرناه.
و مما نلزمهم أن نقول: إذا حكمتم بأن الباري تعالى يتجدد عليه أحكام الإرادة فيما لا يزال، فما المانع من قيام موجباتها به؟
ص: 71
فإن قالوا: لو قامت به لم يخل عنها أو عن ضدها ثم ينساق ذلك إلى الدليل على حدثه؛ قلنا: إنه جاز أن يتصف بأحكام الحوادث من غير أن كان متصفا بنقائضها قبل الاتصاف بها، فما المانع من أن تقوم به الحوادث فيما لا يزال مع خلوه عن أضدادها قبلها؟ ثم أصلكم أن الحي يجوز أن يعري عن الإرادة و أضدادها، و هذا مذهب الدهماء منهم.
و كل ما ذكرناه كلام في أحد القسمين الموعودين في صدر الكلام على البصريين، و هو التعرض لكون الباري تعالى مريدا. فأما الرد عليهم في إثبات الإرادة الحادثة، فسنذكره عند خوضنا في إثبات الصفات إن شاء اللّه، فإنا بعد في إثبات العلم بأحكامها.
الباري تعالى سميع بصير عند أهل العقل، و اختلفت مذاهب أهل البدع و الأهواء.
فذهب الكعبي و أتباعه من البغداديين إلى أن الباري تعالى إذا سمي سميعا بصيرا، فالمعنى بالاسمين كونه عالما بالمعلومات على حقائقها، و إلى ذلك ذهبت طوائف من النجارية.
ص: 72
و ذهب المتقدمون من معتزلة البصرة إلى أن الباري تعالى سميع بصير على الحقيقة، كما أنه عالم على الحقيقة، و زعموا أنه سميع بصير لنفسه.
و ذهب الجبائي و ابنه إلى أن المعنى بكونه سميعا بصيرا، أنه حي لا آفة به. و من أصلهما أن حقيقة السميع و البصير شاهدا يضاهي حقيقتهما غائبا.
و الدليل على أن الباري تعالى سميع بصير على الحقيقة، أن الأفعال دالة على كونه حيا كما سبق تقريره، و الحي يجوز أن يتصف بكونه سميعا بصيرا، و إذا خرج عن كونه سميعا بصيرا لزم اتصافه بكونه مؤفا، إذ كل قابل لنقيضين على البدل لا واسطة بينهما يستحيل خلوه عنهما، فإذا تقرر استحالة كونه مؤفا، تقرر اتصافه بكونه سميعا بصيرا؛ فهذا تحرير الدلالة، و الغرض منها يتبين بأسئلة و انفصالات عنها.
فإن قال قائل: قد بنيتم كلامكم هذا على قبول الباري تعالى الاتصاف بكونه سميعا بصيرا، فبم تنكرون على من يأبى ذلك و ينكره، و يزعم أن الباري تعالى يستحيل عليه قبول السمع و البصر و أضدادهما، كما يستحيل عليه قبول الألوان؟ قلنا: قد وضح أن الحي شاهدا قابل للاتصاف بالسمع و البصر، فإذا اتصف بالحياة تهيأ لقبول السمع و البصر إن لم تقم به آفات؛ ثم إذا سبرنا صفات الحي؛ روما للعثور على ما يصحح قبوله للسمع و البصر، لم يصح على السبر إلا كونه حيا، إذ لو قدرنا مصححا آخر سوى ذلك
ص: 73
لبطل التقدير؛ فإذا وضح أن الحي باين الجماد في صحة قبول السمع و البصر لكونه حيا، لزم من ذلك القضاء بمثله في كون الباري تعالى حيا.
و ليس منكر صحة قبول السمع و البصر و حكمهما، بأسعد حالا ممن يزعم أن الباري تعالى لا يتصف بالعلم و أضداده، مصيرا إلى أنه يستحيل أن يتصف بأحكامها؛ فهذا القدر كاف في غرضنا.
فإن قيل: ما الدليل على امتناع عروّ الشي ء عن أحكام الأضداد مع جواز قبوله للآحاد؟ قلنا:
كل ما يدل على استحالة عرو الجواهر عن المتضادات فهو دليل على ذلك، و قد سبق الإيماء إلى ذلك في أول المعتقد.
فإن قيل: من أركان دليلكم استحالة اتصاف الباري تعالى بالآفات المضادة للسمع و البصر، فما الدليل على ذلك؟ قلنا: هذا مما كثر فيه كلام المتكلمين، و لا نرتضي مما ذكروه في هذا المدخل إلا الالتجاء إلى السمع، إذ قد أجمعت الأئمة و كل من آمن باللّه تعالى على تقدس الباري تعالى عن الآفات و النقائص.
فإن قيل: الإجماع لا يدل عقلا، و إنما دل السمع على كونه دليلا؛ و السمع و إن تشعبت طرقه فمآله كلام اللّه تعالى، و هو الصدق و قوله الحق؛ و الأفعال لا تدل على ثبوت الكلام، بل سبيل إثباته كسبيل إثبات السمع و البصر، كما سنذكره. فلو وقعت الطّلبة في الكلام نفسه، و أسندنا إثباته إلى نفي الآفة، ثم
ص: 74
رجعنا في نفي الآفة إلى الإجماع الذي لا يثبت إلا بالكلام، لكنا محاولين إثبات الكلام بما لا يثبت إلا بعد تقدم العلم بالكلام عليه، و ذلك نهاية العجز؛ قلنا: هذا السؤال عظيم الوقع، يتعين الاعتناء بالانفصال عنه، و يتجه عندنا في درء السؤال أن نقول: المعجزات إذا دلت على صدق الرسل عليهم السلام، و أخبروا بعد ثبوت صدقهم عن الكلام الثابت للّه تعالى على الجملة، ثم أخبروا عن تفاصيل متعلقاته، فيعلم على القطع ما نرومه.
فإن قيل: المعجزات لا تدل على صدق الأنبياء لأعيانها دلالة الأدلة العقلية، و إنما تدل من حيث تنزّل منزلة التصديق بالقول على ما سنذكره في باب المعجزات؛ فإذا كان المعجز يدل من هذا الوجه لأنه يحل محل قول مصدق، فكيف تدل المعجزة على قول، و وجه دليله نزوله منزلة قول؟
قلنا: هذا مخيل ملبس، و لكن الحق يتبين عند التحصيل؛ فإن من ادعى في محفل أنه رسول ملك، و قام على رؤوس الأشهاد و ادعى أنه رسول الملك على من شهد و غاب، و ذلك بمرأى من الملك و مسمع، ثم قال: آية رسالتي أني إذا اقترحت على الملك أن يقوم و يقعد فعل على خلاف المعتاد منه، ثم عقب على ما قال بالاقتراح، فوافقه الملك؛ فيضطر أهل المجلس إلى العلم بكونه رسولا مصدقا من المرسل. و قد لا يخطر لبعضهم كون المرسل متكلما، و قد يحضر المجلس من ينفي كلام النفس و يعتقد ألا كلام إلا العبارات، ثم يستوي الحاضرون في درك
ص: 75
العلم بكونه رسولا، مع اختلافهم في الذهول عن كلامه إذ ذاك و العلم به؛ فاعلم ذلك ترشد.
و هذا الفصل لا يليق بمقدار هذا المعتقد، و لكنا ألفينا فصلا تقدر لدى الإملاء، فضمناه هذا المعتقد، و باللّه التوفيق.
و سبيل إثبات العلم بكون الباري تعالى متكلما، كسبيل إثبات العلم بكونه سميعا بصيرا، و لكن المقصد منه لا يتضح قبل أن نثبت كلام النفس و نرد على منكريه.
فإن قيل: قد وصفتم الباري تعالى بكونه سمعيا بصيرا، و السمع و البصر إدراكان، ثم تثبت شاهدا إدراكات سواهما: إدراك يتعلق بقبيل الطعوم، و إدراك يتعلق بقبيل الروائح، و إدراك يتعلق بالحرارة و البرودة و اللين و الخشونة؛ فهل تصفون الرب تعالى بأحكام هذه الإدراكات، أم تقتصرون على وصفه بكونه سميعا بصيرا؟ قلنا: الصحيح المقطوع به عندنا وجوب وصفه بأحكام الإدراكات، إذ كل إدراك ينفيه ضد فهو آفة، فما دل على وجوب وصفه بأحكام السمع و البصر فهو دال على وجوب وصفه بأحكام الإدراكات.
ثم يتقدس الرب سبحانه و تعالى عن كونه شامّا ذائقا لامسا، فإن هذه الصفات منبئة على ضروب من الاتصالات، و الرب يتعالى عنها. ثم هي لا
ص: 76
تنبى ء عن حقائق الإدراكات؛ فإن الإنسان يقول شممت تفاحة فلم أدرك ريحها؛ و لو كان الشم دالّا على الإدراك، لكان ذلك بمثابة قول القائل: أدركت ريحها و لم أدركه، و كذلك القول في الذوق و اللمس.
الرّب سبحانه و تعالى باق مستمرّ الوجود، و كان الترتيب الذي بنينا عليه الكلام في الصفات يقتضي أن تعدّ هذه الصفة في الأبواب المشتملة على ذكر صفات النفس؛ فإن الذي نرتضيه، أن الباقي باق لنفسه، و ليس كونه باقيا من الأحكام التي توجبها المعاني، و سنوضح ذلك من بعد إن شاء اللّه عز و جل.
و كلّ ما دلّ على قدم الباري تعالى، و استحالة عدمه، و وجوب وجوده، فهو دال على كونه تعالى باقيا.
و الذي ذكرناه لمع مغنية في إثبات العلوم بأحكام الصفات الموجبة.
و نحن الآن نخوض في إثبات العلم بالصفات الموجبة للذات أحكامها، مستعينين باللّه تعالى.
مذهب أهل الحق أن الباري سبحانه و تعالى حيّ، عالم، قادر؛ له الحياة القديمة، و العلم القديم، و القدرة القديمة، و الإرادة القديمة.
ص: 77
و اتفقت المعتزلة و من تابعهم من أهل الأهواء على نفي الصفات، ثم اختلفت آراؤهم في التعبير عن وصفه بأحكام الصفات؛ فقال قائلون: إنه حيّ، عالم قادر لنفسه.
و اختار آخرون عبارة أخرى، فقالوا: هذه الأحكام ثابتة للذات لكونه على حالة هي أخص صفاته، و تلك الحالة توجب له كونه حيّا عالما قادرا.
و ذهب ذاهبون من نفاة الصفات إلى أن الباري، تعالى عن قولهم، حيّ، عالم، قادر، لا لعلل و لا لنفسه.
و نحن نرى أن نقدّم على الخوض في الحجاج فصلين؛ يشتمل أحدهما على إثبات الأحوال، و الردّ على منكريها؛ و يشتمل الثاني على جواز تعليل الواجب من الأحكام. فإذا نجزا. خضنا بعدهما في الحجاج.
الحال صفة لموجود، غير متصفة بالوجود و لا بالعدم.
ثم من الأحوال ما يثبت للذوات معلّلا، و منها ما يثبت غير معلّل. فأما المعلل منها، فكل حكم ثابت للذات عن معنى قائم بها؛ نحو كون الحيّ حيّا، و كون القادر قادرا. و كل معنى قام بمحل، فهو عندنا يوجب له حالا، و لا يختص إيجاب الأحوال بالمعاني التي تشترط في ثبوتها الحياة.
ص: 78
و أما الحال التي لا تعلّل، فكل صفة إثبات لذات من غير علة زائدة على الذات، و ذلك كتحيز الجوهر فإنه زائد على وجوده. و كل صفة لوجود لا تنفرد بالوجود، و لا تعلل بموجود، فهي من هذا القسم؛ و يندرج تحته كون الموجود عرضا، لونا، سوادا، كونا، علما، إلى غير ذلك.
و أنكر معظم المتكلمين الأحوال، و زعموا أن كون الجوهر متحيزا عين وجوده، و كذلك قولهم في كل ما حكمنا بكونه حالا لموجود زائدا على وجوده.
و الدليل على إثبات الأحوال، أن من علم بوجود الجوهر و لم يحط علما بتحيزه، ثم استبان تحيزه فقد استجد علما متعلقا بمعلوم، و يسوغ تقدير العلم بالوجود دون العلم بالتحيز. و إذا تقرر تغاير العلمين، فلا يخلو معلوم العلم الثاني من أمرين: إما أن يكون هو المعلوم بالعلم الأول، و إما أن يكون زائدا عليه، و باطل أن يكون المعلوم بالعلم الثاني هو المعلوم بالعلم الأول لأوجه:
منها، أن العاقل يقطع عند الاتصاف بالعلم الثاني، أنه أحاط بما لم يحط به قبل، و استدرك ما لم يستدركه أولا، و يجوز تقدير الجهل بالتحيز مع العلم بالوجود؛ فلو كان تحيز الجوهر وجوده، لاستحال ذلك ما يستحيل أن يعلم الموجود من يجهله في حالة واحدة.
و من الدليل على ذلك، أنه إذا اتحد معلوم العلمين الحادثين، لم يتقرر القضاء باختلافهما قياسا على العلمين بوجود الجوهر و تحيزه. و ربما يطلق نفاة الأحوال، أن الشي ء يعلم من وجه و يجهل من وجه، و التعرض للوجوه إثبات الأحوال.
ص: 79
و لا يستغني خائض في هذا الفنّ عن التعرّض للأحوال؛ إما بتسميتها أحوالا، أو وجوها، أو صفات نفس.
و لا ينبغي أن يكيع (1)ذو التحصيل من تهويل نفاة الأحوال، بأن الحال لا يتصف بالوجود و لا بالعدم، فإن قصارى ما يذكرونه استبعاد و ادّعاء لا يمكن استناده إلى دعوى ضرورة و تمسك بدليل.
و مذهبنا أن المعلومات تنقسم إلى وجود، و عدم، و صفة وجود لا تتصف بالوجود و العدم.
فإذا صح(2) ما قلنا، فاعلم أن إثبات العلم بالصفة الأزلية لا يتلقى إلا من اعتبار الغائب بالشاهد، و التحكم بذلك من غير جمع يجر إلى الدهر و الكفر، و كل جهالة تأباها العقول؛ فإن من قال يقضى على الغائب بحكم الشاهد من غير جمع، لزمه أن يحكم بكون الباري تعالى جسما محدودا من حيث لم يشاهد فاعلا إلا كذلك، و يلزم منه القضاء بتعاقب الحوادث إلى غير أول من حيث لم يشاهدها إلا متعاقبة، إلى غير ذلك من الجهالات.
فإذا لم يكن من جامع بدّ، فالجامع بين الشاهد و الغائب أربعة:
ص: 80
أحدها العلة؛ فإذا ثبت كون حكم معلولا بعلة شاهدا و قامت الدلالة عليه، لزم القضاء بارتباط العلة بالمعلول شاهدا و غائبا، حتى يتلازما و ينتفي كل واحد منهما عند انتفاء الثاني، و هذا نحو ما حكمنا بأن كون العالم عالما شاهدا، معلل بالعلم. و سنوضح ذلك على قدر الكتاب، إذا خضنا في الحجاج.
الطريقة الثانية في الجمع الشرط؛ فإذا تبين كون الحكم مشروطا بشرط شاهدا، ثم يثبت مثل ذلك الحكم غائبا، فيجب القضاء بكونه مشروطا بذلك الشرط اعتبارا بالشاهد؛ و هذا نحو حكمنا بأن كون العالم عالما مشروط بكونه حيّا، فلما تقرر ذلك شاهدا اطرد غائبا.
و الطريقة الثالثة الحقيقة؛ فمهما تقررت حقيقة شاهدا في محقق اطردت في مثله غائبا، و ذلك نحو حكمنا بأن حقيقة العالم، من قام به العلم.
و الطريقة الرابعة في الجمع الدليل؛ فإذا دلّ على مدلول عقلا لم يوجد الدليل غير دال شاهدا و غائبا، و هذا كدلالة الأحداث على المحدث. فهذا أحد الفصلين الموعودين.
فأما الفصل الثاني، فهو يشتمل على تعليل الواجب و الرّد على منكريه. و الذي تبني المعتزلة فاسد معتقدهم في نفي الصفات عليه، مصيرهم إلى أن كون الباري تعالى عالما واجب، و الواجب يستقل بوجوبه عن مقتض يقتضيه؛
ص: 81
و ليس كذلك كون العالم عالما شاهدا، فإنه جائز ممكن، فإذا ثبت افتقر إلى مخصص أو مقتض.
و شبهوا الحكم الواجب و الجائز، بالوجود الواجب و الجائز. و القديم سبحانه و تعالى لما كان واجب الوجود، لم يتعلق وجوده بمقتض؛ و الحادث لما كان جائز الوجود، افتقر وقوعه إلى مقتض.
و هذا الذي ذكروه دعوى عريّة، فيقال لهم: بم تنكرون على من يزعم أن الحكم الواجب يتعلق بموجب واجب؟ و الحكم الجائز يتعلق بعلة جائزة؟
و أما استشهادهم بالوجود، فلا محصول له؛ فإنا لم نحكم بما قالوه لوجوب وجود القديم سبحانه و تعالى، بل قضينا به من حيث انتفت الأولية عن وجود الباري سبحانه، و ما لا أول له يستحيل أن يتعلق بفاعل، فإن لكل فعل مبتدأ؛ فاستحال لذلك تعلقه بفاعل، و استحال أيضا تعلقه بعلة، فإن الوجود لا يعلل شاهدا و غائبا.
ثم نقول لهم: قد عولتم فيما يعلل على الجوار، و قضيتم بأن الحكم إنما يعلل بجوازه، ثم عكستم الجواز و زعمتم أن الواجب لا يعلل، و ما ذكرتموه يبطل في الطرد و العكس.
فأما تعليل الجائز، فباطل بالوجود؛ فإنه جائز للحوادث، و هو غير معلل.
فإن قالوا: وجود الحوادث و إن لم يعلل فهو متعلق بالفاعل، و من حكم الجائز، أن يتعلق بمقتض، ثم قد يكون المقتضى علة، و قد يكون فاعلا؟ قلنا:
ص: 82
الوجود عندنا حال للجوهر، و الجوهر كان في عدمه جوهرا، ثم طرأ عليه حال الوجود؛ فهلا زعمتم أن كون العالم عالما شاهدا حال يطرأ على الذات الموصوفة بخصائص الصفات، وجودا و عدما؟ و ذلك يقضي إلى نفي العلل شاهدا، و لا محيص عن ذلك.
و قولهم يستقل الواجب بوجوبه، يبطل عليهم بأشياء: منها، أن كون العالم عالما شاهدا إذا ثبت فقد التحق بالواجبات، من حيث لا ينتفي ما وقع حتى يصير كأنه لم يقع، فيجب أن لا يكون الحال الواقع معللا.
و الدليل على ذلك أصلان من مذاهب المعتزلة: أحدهما، أنهم قالوا: الحادث غير مقدور في حال حدوثه، و إنما تتعلق القدرة به قبل الحدوث؛ فكما استقل الحادث بالوقوع عن تعلق القدرة، فليستقل الحال عند الوقوع عن إيجاب العلة.
و الأصل الثاني، أنهم أثبتوا صفات سموها تابعة للحدوث، و زعموا أنها لا تقع بالقدرة لوجوبها، و عدّوا من ذلك تحيز الجوهر، و قيام العرض بالمحل.
و منها، كون العالم عالما المعلل بالعلم؛ فإذا ألحقوا الحال الذي فيه نزاعنا بالصفات الواجبة التابعة للحدوث، و أخرجوه عن كونه مقدورا و لم يخرجوه عن كونه معلولا، فدل مجموع ذلك على أن الوجوب لا ينافي التعليل.
و مما يبطل ما قالوه، أنهم طردوا الشرط شاهدا و غائبا، و حكموا بأن كون العالم عالما مشروط بكونه حيّا، ثم قضوا بذلك في كون الباري تعالى عالما قادرا؛
ص: 83
فإذا لم يفصلوا بين الواجب و الجائز في حكم الشرط، لم يسغ لهم الفصل في حكم العلة. و هذا القدر كاف فيما نبغيه.
فإذا ثبت مضمون الفصلين خضنا بعدهما في الحجاج. و نحن الآن نقيم على الخصوم ثلاثة أدلة، يفضي كل واحد منها إلى القطع، و اللّه المستعان.
فالطريقة الأولى، أن نقول: قد سلمتم لنا أن كون العالم عالما حكم ثابت للذات، كما أن كون المريد مريدا حكم ثابت للذات، ثم منعتم كون الباري تعالى مريدا لنفسه؛ و كل ما صدّكم عن ذلك في كونه مريدا فهو متقرر في كونه عالما، و يتضح الجمع بالسبر و التقسيم.
فنقول: امتناع كون الباري سبحانه و تعالى مريدا لنفسه لا يخلو؛ إما أن يستند إلى وجوب تعليل هذا الحكم غائبا، كما ثبت تعليله شاهدا؛ فإن كان الأمر كذلك، فيجي ء من مضمونه تعليل كونه تعالى عالما طردا للعلة المقررة شاهدا، و إن كان ما ذكرناه في حكم الإرادة يستند إلى ما هذوا به، من أنه لو كان مريدا لنفسه لكان مريدا لكل المرادات، و قد أوضحنا إبطال ذلك عليهم عند كلامنا في حكم الإرادة.
فإذا بطل معلولهم في منع كون الباري تعالى مريدا لنفسه، فلا يبقى بعده إلا ما ذكرناه. و ليس يجري كون المريد مريدا مجرى كون الفاعل فاعلا، فإن للمريد بكونه مريدا حكما و حالا على التحقيق، و ليس للفاعل بكونه فاعلا حال؛ فهذه طريقة قاطعة فيما نلتمسه.
ص: 84
و الطريقة الثانية أن نقول: قد ثبت أن كون العالم عالما شاهدا معلل بالعلم، و العلة العقلية مع معلولها يتلازمان، و لا يجوز تقدير واحد منهما دون الثاني؛ فلو جاز تقدير كون العالم عالما دون العلم، لجاز تقدير العلم من غير أن يتصف محله بكونه عالما، و لا معنى لإيجاب العلم حكمه، إلا أنه يلازمه، فإنه لا يثبته إثبات القدرة مقدورها؛ فلو جاز ثبوت الحكم دون العلة لوجوبه، لجاز وجود العلة دون حكمها لوجوبها.
و العبارات المتداولة بين الأصوليين، أن تسمية العالم عالما تقتضي علة موجبة، موضوعة للتفاهم و الميز بين ذات و ذات، فإذا ثبت ذلك شاهدا وجب القضاء به غائبا.
و إن قالوا: كون العالم عالما شاهدا إنما يعلل لجوازه، فقد قدمنا ما يبطل ذلك في النفي و الإثبات.
فإن قالوا: كون العالم عالما غائبا على خلاف كون العالم عالما شاهدا، و إذا ثبت حكم معلل بعلة، فإنما يلزم تعليل مثل ذلك الحكم بالعلة طردا، قلنا: الوجه الذي يقتضي العلم شاهدا حكما، يقتضيه غائبا. و إذا اختلف العلمان فلا يثبت حكم الاختلاف لحكميهما من الوجه الذي يقتضي العلة معلولها لأجله؛ فإن العلم شاهدا يخالف العلم القديم عندنا، بكونه حادثا عرضا مختصا بمتعلق واحد إلى غير ذلك. و العلم بهذه الوجوه لا يوجب كون العالم عالما، و إنما يوجبه من حيث يكون علما، و ذلك ثابت شاهدا و غائبا. ثم ما ألزمونا في تباين الحكمين في حكم العلة، يلزمهم في تباينهما في حكم الشرط.
ص: 85
و الطريقة الثالثة، و هي عمدة شيخنا رضي اللّه عنه، أن نقول: العلم المتعلق بالمعلوم علم.
فإذا زعمتم أن الباري تعالى علم بالمعلوم، و المعلوم في حقه محاط به، فلا يتقرر معلوم محاط به لا يتعلق به متعلق. ثم المتعلق بالمحاط به يستحيل أن يكون خارجا من قبيل العلوم، و لا معنى لتعلق العلم بالمعلوم إلا كون المعلوم محاطا به.
و هذا آكد على أصول المعتزلة؛ فإنهم قالوا: تعلق العلمين بالمعلوم الواحد يوجب تماثلهما، و بنوا على ذلك مماثلة العلم القديم- لو ثبت- للعلم الحادث. و ذلك قاطع إذا تأملته، و باللّه التوفيق.
و معوّل نفاة الصفات على طرق: منها، ادّعاؤهم منع تعليل الواجب كما قدمناه، و قد سبق الاعتراض عليه بما فيه مقنع.
و مما يتمسكون به أيضا، أن قالوا: لو أثبتنا صفات قديمة لكانت مشاركة للباري تعالى في القدم، و هو أخص صفات الذات، و الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك فيما عداه من الصفات، و مساق ذلك يقضي بكون الصفات آلهة.
و هذا الذي ذكروه تعرض للدعاوى من غير برهان. فأما قولهم الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك فيما عداه، فهم فيه منازعون؛ ثم لو سلم ذلك لهم جدلا، نوزعوا في كون القدم أخص أوصاف الباري تعالى، و لا يجدون إلى إثبات سبيلا.
ص: 86
ثم يقال لهم: الإرادة التي أثبتموها للباري تعالى حادثة قائمة، لا بمحل، مثل على زعمكم للإرادة الثابتة للعبد القائمة به إذا تعلقتا بمتعلق واحد، و هما مشتركتان في الأخص، و يثبت لأحدهما وجوب القيام بالمحل، و يستحيل ذلك على الثانية، و هذا ينقض ما حاولوه من وجوب اشتراك المشتركين في الأخص في جميع الصفات.
على أنا نقول لهم: منعكم تعليل الواجب يناقض مصيركم إلى أن الاجتماع في الأخص يوجب الاجتماع فيما عداه؛ فإن تماثل المثلين واجب، و تعرضكم لتعليله تصريح بتعليل الواجب.
و مما يتمسكون به أن قالوا: علم الباري تعالى على زعمكم يتعلق بما لا يتناهى من المعلومات على التفصيل، و هو في حكم العلوم المختلفة الحادثة، إذ لا يتعلق العلم الحادث بالسواد و البياض؛ فإذا تعلق علم الباري بالمعلومات المختلفة كان في حكم العلوم الحادثة، و إذا لم يبعد ذلك لم يبعد أيضا كونه في حكم القدرة، و إن كانت القدرة و العلم مختلفين شاهدا، و يلزم من مفاد ذلك الاجتزاء بصفة واحدة، تكون في حكم العلوم و الحياة و القدرة.
و هذا الذي ذكروه مما لا يلزم الجواب عنه نظرا، فإنه كلام منهم في تفصيل الصفات مع مصيرهم إلى نفي أصلها، ثم إذا أوضحنا فيه معتقدنا و إن لم يكن يلزمنا في طرق الحجاج، قلنا:
القضية العقلية تدل على إثبات الصفة على الجملة، فأما كون العلم زائدا على القدرة فمما لا يتوصل القطع إليه عقلا. و السبيل فيه التمسك بأدلة السمع، فإن المتكلمين في الصفات بالنفي و الإثبات
ص: 87
مجمعون على نفي صفة في حكم العلم و القدرة، فمن رام إثبات صفة في حكمها كان خارقا للإجماع.
فإن قيل: إذا لم يبعد ثبوت علم في حكم علوم، فما المانع من مصيرنا إلى أن الباري تعالى عالم بالمعلومات لنفسه، قادر عليها لنفسه، و تكون نفسه في حكم العلم و القدرة، و ذلك يفضي إلى الاستغناء بالذات عن الصفات؟ قلنا: هذا ليس بالاستدلال، فإنكم بنيتم قولكم هذا على أصل تعتقدون فساده؛ إذ العلم الذي اعتقدناه غير ثابت عندكم، فكيف تبنون مذهبكم على ما تعتقدون بطلانه؟
ثم مضمون ما عولتم عليه يقضي بما توافقوننا على بطلانه؛ و ذلك أن ذات الباري تعالى لو كان في حكم العلوم لكانت علما، و هذا ما لا ينتحله أحد من أهل الملة. و قد قال أبو الهذيل (1): الباري تعالى عالم بعلم، و علمه نفسه، و نفسه ليست بعلم، و عدّ هذا من فضائحه و مناقضاته. و هو مع مفارقة ما أنكره سائر المعتزلة، ينكر كون ذات الباري تعالى علما و قدرة. و أحق الناس بالتزام ذلك المعتزلة؛ فإنهم قالوا: لو ثبت للباري تعالى علم متعلق بمعلوم علمنا، لكن مثلا لعلمنا؛ فلو قضوا بكون ذاته في حكم العلوم، لألزموا كون ذاته علما، و هو مما يأبونه أصلا.
ص: 88
فإن قيل: إن كان ما ذكرتموه دفعا لكلام الخصم، فبم تدفعون ذلك عن أنفسكم، و قد زعمتم أن العقل يقضي بإثبات الصفة على الجملة، و الكلام في التفاصيل موقوف على الأدلة السمعية؟ قلنا:
هذا مما لا يحتمل هذا المعتقد بسطه، و لكن القدر اللائق به أن العقل يدل على إثبات العلم، ثم المصير إلى أن العلم زائد على النفس مدركه السمع، فإذا دل العقل على إثبات العلم، و انعقد الإجماع على أن وجود الباري تعالى ليس بعلم، فيحصل من مدلول السمع و العقل إثبات علم زائد على الوجود، و باللّه التوفيق.
قد ذكرنا الدليل على إثبات كون الباري تعالى مريدا عند تعرضنا لإثبات العلم بأحكام الصفات. ثم مذهب أهل الحق أن الباري تعالى مريد بإرادة قديمة. و قد زعمت المعتزلة البصريون أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل، و ذلك باطل من أوجه:
منها، إن إرادته لو كانت حادثة لا فتقرت إلى تعلق إرادة بها؛ فإن كل فعل ينشئه الفاعل، و هو عالم به و بإيقاعه على صفة مخصوصة في وقت مخصوص، فلا بد أن يكون قاصدا إلى إيقاعه؛ و نفي القصد إلى إيقاع فعل، مع العلم به، يلزم صاحبه نفي المقصود إلى إيقاع جميع الأفعال.
فإذا قالوا: الإرادة يراد بها و هي لا تراد في نفسها، لم يكترث بقولهم، و ألزموا ما ذكرناه من استحالة إنشاء فعل مع العلم به من غير قصد إليه.
ص: 89
و قد ادعى بعض المحققين في ذلك الضرورة، و هو غير مبعد في دعواه.
و لو ساغ للبصريين ما قالوه، لساغ لجهم أن يقول: الباري تعالى يخلق لنفسه علوما حادثة بالحوادث يجب أن يعلم الحوادث بها، و لا يجب أن يعلم العلوم بأنفسها بعلوم أخرى، و هذا مما لا فصل فيه.
ثم نقول: قد وافقتمونا على أن المتماثلين يجب اشتراكها في الواجبات و الجائزات و ما يستحيل، ثم أوجبتم لإرادتنا القيام بالمحال؛ فالتزموا ذلك في إرادة الباري تعالى.
ثم يلزمهم قيام إرادة الباري تعالى عن زعمهم، بالجماد. فإن حاولوا دفع ذلك، و قالوا الإرادة تستدعي محلا مخصوصا و بنية مخصوصة و حياة، قيل لهم: إثباتكم إرادة لا في محل، نفي للمحل و البنية و الصفة التي أشرتم إليها؛ فإذا ساغ نفي أصل المحل، لم يبعد نفي شرط المحل.
ذهب جهم (1) إلى إثبات علوم حادثة للرب، تعالى عن قول المبطلين. و زعم أن المعلومات إذا تجددت أحدث الباري سبحانه و تعالى علوما متجددة، بها يعلم المعلومات الحادثة، ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات في وقوعها متقدمة عليها.
ص: 90
و الذي ذكره خروج عن الدين و مخالفة لإجماع المسلمين، و إضراب عن قضية العقول.
و سبيل الرد عليه في مدارك العقل يداني سبيل الرد على البصريين، في اعتقادهم الإرادات الحادثة الثابتة على زعمهم للّه تعالى في غير محالّ.
فنقول لجهم: إن افتقرت الإرادات إلى علوم متعلقة بها، فلتفتقر العلوم الحادثة إلى علوم أخر متعلقة بها، بأنها مشاكة للمعلومات في كونها أفعالا حوادث؛ و ذلك إن التزمه تجر إلى إثبات علوم لا نهاية لها، و هي متعاقبة حادثة، و مقاده تسويغ حوادث لا أول لها. و إن لم يلتزم ذلك، لزمه من استغناء العلوم عن علوم حدوثها، استغناء جملة الحوادث عن تعلق العلوم بها.
ثم العلوم الحادثة عند جهم لا تخلو: إما أن تكون ثابتة في غير محل، أو قائمة بأجسام، أو قائمة بذات الباري تعالى؛ فإن زعم أنها ثابتة في غير محل، ردّ عليه بما رد على مثبتي الإرادات الحادثة في غير محل و إن زعم أنها تقوم بذات الرب، كان الرد عليه كالرد على الكرامية الصائرين إلى أن الحوادث تقوم بذات الرب سبحانه و تعالى عن قولهم و إن زعم أنها تقوم بأجسام، لزم أن يجوّز قيام علم بجسم و المتصف بحكمه جسم آخر، طردا لما يجوزه من قيام العلم بجسم مع رجوع حكمه إلى اللّه تعالى. فإذا بطلت الأقسام، و لا مزيد عليها، أذن بطلانها بفساد المذهب المنقسم إليها.
فإن قيل: الباري سبحانه كان عالما في أزله بأن العالم سيقع، فلما وقع فيما لا يزال كان ذلك معلوما متجددا، و يتصف الباري تعالى عند وقوع العالم بكونه
ص: 91
عالما بوقوعه؛ و إذا تجدد له حكم و اتصاف اقتضى ذلك تجدد موجب للحكم و مقتض له، و ذلك يقضي بالعلوم المتجددة.
قلنا لا يتجدد للباري سبحانه و تعالى حكم لم يكن، و لا تتعاقب عليه الأحوال، إذ يلزم من تعاقبها ما يلزم من تعاقب الحوادث على الجواهر؛ بل الباري تعالى متصف بعلم واحد، متعلق بما لم يزل، و لا يزال، و هو يوجب له حكم الإحاطة بالمعلومات على تفاصيلها، و لا يتعدد علمه بتعدد المعلومات، و إن كانت العلوم الحادثة تتعدد بتعدد المعلومات.
ثم كما لا يتعدد إذا تعددت المعلومات، فكذلك لا يتجدد إذا تجددت.
و الذي يوضح الحق في ذلك؛ أن من اعتقد بقاء العلم الحادث، ثم صور علما متعلقا بأن سيقدم زيد غدا، و قرر استمرار العلم بتوقع قدومه إلى قدومه، فإذا قدم لم يفتقر إلى علم متجدد بوقوع قدومه، إذ قد سبق له العلم بقدومه في الوقت المعين.
و آية ذلك أنا لو قدرنا اعتقاد دوام العلم كما صورناه، و لم نفرض عند وقوع القدوم علما آخر سوى ما قدمنا دوامه، و قلنا لا يتعلق العلم السابق بالوقوع، للزم كونه جاهلا بالوقوع في وقته أو غافلا عنه مع تقدير دوام العلم بالقدوم المرقوب في الوقت المعين، و ذلك باطل على الضرورة.
و ليس من معتقدنا المصير إلى بقاء العلوم الحادثة، و لكن الأدلة العقلية تبني على الحقائق مرة، و على تقدير اعتقادات أخرى، فإذا لم يلزم شاهدا تجدد علوم
ص: 92
عند تجدد المعلومات في حق من سبق له العلم بوقوعها في الاستقبال، فلأن لا يلزم ذلك في حق الباري تعالى أولى فافهم.
الباري سبحانه و تعالى متكلم، آمر، ناه مخبر، واعد، متواعد. و قد قدمنا في خلال إثبات أحكام الصفات المعنوية، الطريق إلى إثبات العلم بكون الرب تعالى متكلم عند إسنادنا نفي النقائص إلى السمع، و توجيهنا على أنفسنا السؤال عما يثبت للسمع.
فإذا وضح كون الباري تعالى متكلما، فقد آن أن نتكلم في صفة كلامه.
فاعلموا وقيتم البدع، أن من مذهب أهل الحق: أن الباري سبحانه و تعالى متكلم بكلام أزلي، لا مفتتح لوجوده.
و أطبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام، و لم يصر صائر إلى نفيه، و لم ينتحل أحد في كونه متكلما نحلة تفاة الصفات في كونه عالما قادرا حيّا.
ثم ذهبت المعتزلة، و الخوارج «1»، و الزيدية «2»، و الإمامية «3»، و من عداهم من أهل الأهواء، إلى أن كلام الباري، تعالى عن قول الزائغين، حادث مفتتح الوجود.
ص: 93
و صار صائرون من هؤلاء إلى الامتناع من تسميته مخلوقا مع القطع بحدثه، لما في لفظ المخلوق من إيهام الخلق، إذ الكلام المخلوق هو الذي يبديه المتكلم تخرصا من غير أصل.
و أطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام اللّه تعالى، و ذهبت الكرامية إلى أن كلام اللّه قديم، و القول حادث غير محدث، و القرآن قول اللّه، و ليس بكلام اللّه؛ و كلام اللّه عندهم القدرة على الكلام، و قوله حادث قائم بذاته، تعالى عن قول المبطلين؛ و هو غير قائل بالقول القائم به، بل قائل بالقائلية، و كل مفتتح وجوده قائم بالذات، فهو حادث بالقدرة غير محدث؛ و كل مفتتح مباين للذات، فهو محدث بقوله: «كن» لا بالقدرة، في هذيان طويل، لا يسع هذا المعتقد استقصاؤه.
و غرضنا من إيضاح الحق و الرد على متنكبيه لا يتبين إلا بعد عقد فصول في ماهية الكلام و حقيقته شاهدا، حتى إذا وضحت الأغراض منها انعطفنا بعدها إلى مقصدنا. و قد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا المعتقد على صغر حجمه، و آثرنا إجراءه على خلاف ما صادفنا من معتقدات الأئمة؛ و هذا الشرط يلزمنا طرقا من البسط في مسألة الكلام، و ها نحن خائضون فيه.
ص: 94
اعلم، أرشدك اللّه تعالى، أن المعتزلة و مخالفي أهل الحق قد تخبطوا في حقيقة الكلام.
و ها نحن نومئ إلى جمل من ألفاظهم، ثم نتعقبها بالنقض.
و مما ذكره قدماؤهم: أن الكلام حروف منتظمة، و أصوات منقطعة، دالة على أغراض صحيحة، و هذا باطل؛ إذ الحدّ ما يحوي آحاد محدود، و الحرف الواحد قد يكون كلاما مفيدا، فإنك إذا أمرت من «وقى» و «وشى» قلت «ق» و «ش»، و هذا كلام و ليس بحروف و أصوات.
فإن قيل: الحرف الواحد لا ينطق به، بل إن جرّد الأمر من هذه الأدوات وصل بهاء الاستراحة، فقيل «قه» و «شه»، فلم يستقلّ الحرف الواحد بنفسه، و هذا لا ينجيهم عما أريد بهم، فإن «ق» في درج الكلام، و وصله كلام، و هو حرف واحد، و إنما غرضنا إيضاح ذلك.
ثم لا معنى للتقييد بالإفادة، فإن من لفظ بكلمات لا تفيد، يقال: تكلم و لم يفد، فلا معنى للتقييد بالإفادة.
ثم نقول: الحروف أنفس الأصوات، فلا معنى لتكررها، و الحدود يتوقى فيها التكرير الذي لا يفيد.
ص: 95
فإذا قالوا: الكلام أصوات مقطعة، و حروف منتظمة، فتقديره الكلام أصوات و أصوات، و إذا حذفوا الحروف، قيل لهم: الأصوات المقطعة لا تفيد لأنفسها ما لم يصطلح على نصبها أدلة، فإن ارتضيتم ذلك و اكتفيتم به لزمكم على مساقه تسمية نقرات على أوتار مصطلح عليها كلاما، و هذا القدر كاف في تتبع حدهم.
فإن قال قائل: ما حد الكلام عندكم؟ قلنا: من أئمتنا من يمتنع من تحديد الكلام، و نبينه بالتفصيل كما سنوضحه عند ذكرنا ماهية الكلام.
و جملة المعلومات لا تضبطها الحدود؛ بل منها ما يحد، و منها ما لا يحد؛ كما أن منها ما يعلل، و منها ما لا يعلل.
و قال شيخنا رحمه اللّه: الكلام ما أوجب لمحله كونه متكلما و هذا فيه نظر عندنا.
و الأولى، أن نقول: الكلام هو القول القائم بالنفس، و إن رمنا تفصيلا، فهو القول القائم بالنفس، الذي تدل عليه العبارات و ما يصطلح عليه من الإشارات.
قد أنكرت المعتزلة الكلام القائم بالنفس، و زعموا أن الكلام: هو الأصوات المتقطعة، و الحروف المنتظمة، و نصوا كلاما قائما بالنفس سوى العبارات الآئلة إلى الحروف و الأصوات.
ص: 96
و ربما يثبت ابن الجبائي كلام النفس، و يسميه الخواطر، و يزعم أن تلك الخواطر يسمعها و يدركها بحاسة السمع. و ذهب الجبائي إلى أن الأصوات المتقطعة على مخارج الحروف ليست بكلام، و إنما الكلام الحروف المقارنة للأصوات، و هي ليست بأصوات و لكنها تسمع إذا سمعت الأصوات.
و ذهب أهل الحق إلى إثبات الكلام القائم بالنفس، و هو الفكر الذي يدور في الخلد(1)، و تدل عليه العبارات تارة و ما يصطلح عليه من الإشارات و نحوها أخرى.
و الدليل على إثبات الكلام القائم بالنفس: أن العاقل إذا أمر عبده بأمر، وجد في نفسه اقتضاء الطاعة منه وجدانا ضروريا.
ثم إنه يدل على ما يجده ببعض اللغات و بضروب من الإشارات أو برقوم تسمى الكتبة(2).
فإن زعموا أن ما ذكرنا من الأمر إنما هو إرادة الآمر امتثال المأمور لأمره، فذلك باطل، فإن الآمر قد يأمر بما لا يريد أن يمتثل المخاطب فيه أمره، و إن كان يجد في هواجس النفس الاقتضاء منه الذي هو مدلول العبارة. و سندل من بعد على أن الآمر الموجب لا يجب كونه مريدا للفعل المأمور به.
ص: 97
فإن قالوا: الذي يجده في نفسه إرادة تجعل اللفظ الصادر منه أمر على جهة ندب أو إيجاب، و هذا باطل من أوجه؛ أحدها أن اللفظة تتصرم مع استمرار وجدان الاقتضاء في النفس، و الماضي لا يراد بل يتلهف عليه، و على اضطرار نعلم أن ما نجده بعد انقضاء اللفظ ليس تلهفا على منقض. و مما يوضح ذلك أن اللفظة ترجمة عما في الضمير و هذا مما تقضي به العقول، و ليست اللفظة ترجمة عن إرادة جعلها على صفة، بل هي ترجمة اقتضاء و إيجاب، و لا يجحد ذلك محصل.
فإن قيل: الاقتضاء ضرب من الاعتقاد، كان محالا؛ فإن الاعتقاد إما أن يكون ظنا أو علما أو جهلا، إلى غير ذلك من صنوف الاعتقادات، و الذي يجد من نفسه الاقتضاء يقطع بأنه ليس بعلم و لا ظن و لا جهل و لا حدس و لا تخمين. و الذي يحقق ذلك أن ما ألزمونا من جعل الاقتضاء إرادة و اعتقادا، يلزمهم القول به في النظر، فلو قال قائل: النظر إرادة علم بالمنظور فيه أو هو من ضروب الاعتقادات، فلا ينفصلون عن ذلك بما يوضح كون النظر زائدا على الإرادات و الاعتقادات إلا و سبيلهم يطرد لنا في إثبات غرضنا.
و من الدليل على إثبات كلام النفس أن قول القائل: «افعل» قد يتضمن استحبابا و قد يتضمن إيجابا، و قد يقتضي إباحة، و قد يرد مورد النهي.
ص: 98
فإذا دل على إيجاب يستحيل أن يكون هو الإيجاب بنفسه، فإن صورة اللفظ في إرادة الإيجاب كصورة اللفظ في إرادة الاستحباب، إذ هو أصوات متقطعة ضربا من التقطع، و الأصوات لا تختلف في انقسام جهات الاحتمالات على قطع. فيلزم المصير إلى أن الإيجاب معنى في النفس، ثم تعتور عليه الدلالات بالعبارات و غيرها من الأمارات.
فإن قيل: ما ألزمتمونا في مرامكم ينعكس عليكم في كون اللفظ دليلا على ما في النفس، فإن الدليل على الإيجاب يجب أن يتميز عن الدليل على الاستحباب، قلنا: ليس يرجع تمييز الدليلين إلى أنفس الأصوات، و لكن إذا اقترنت القرائن بالألفاظ و شهدت الأحوال، اضطر المخاطب إلى درك مقصوط اللافظ. و ما ذكرناه من قرائن الأحوال ليست من الكلام عند المخالفين، فهذا القدر مغن في مدارك العقل.
و إن رددنا إلى إطلاق أهل اللسان، عرفنا قطعا أن العرب تطلق كلام النفس و القول الدائر في الخلد، و تقول: كان في نفسي كلام، و زورت في نفسي قولا، و اشتهار ذلك يغني عن الاستشهاد عليه بنثر لناثر أو شعر لشاعر، و قد قال الأخطل:
إن الكلام لفي الفؤاد و إنما***جعل اللسان على الفؤاد دليلا
ص: 99
فإن قال المخالف: الألفاظ المفيدة يسميها العقلاء كلاما على الإطلاق، و يقولون سمعنا كلاما و مرامهم ما أدركوه من العبارات قلنا: الطريقة المرضية عندنا أن العبارات تسمى كلاما على الحقيقة، و الكلام القائم بالنفس كلام، و في الجمع بينهما ما يدرأ تشغيب المخالفين.
و من أصحابنا من قال الكلام الحقيقي هو القائم بالنفس، و العبارات تسمى كلاما تجوزا كما تسمى علوما تجوزا؛ إذ قد يقول القائل سمعت علما و أدركت علوما، و إنما يريد إدراك العبارات الدالة على العلوم، و رب مجاز يشتهر اشتهار الحقائق.
المتكلم عند أهل الحق من قام به الكلام. و الكلام عند مثبتي الأحوال منهم يوجب لمحله حالا و هي كونه متكلما، و ينزل الكلام في ذلك منزلة العلوم و القدر و نحوها من الصفات الموجبة لمحالها الأحكام.
و ذهبت المعتزلة، و كل قائل بأن كلام اللّه تعالى حادث، إلى أن كون المتكلم متكلما من صفات الأفعال، و المتكلم عندهم من فعل الكلام. ثم ليس للفاعل من فعله حكم يرجع إلى ذاته، إذ المعنى بكون الفاعل فاعلا عندهم وقوع الفعل منه، و على موجب ذلك لم يشترطوا قيام الكلام بالمتكلم، كما لا يجب قيام الفعل بالفاعل، و هو من أهم ما يعتني به في هذا الفصل.
ص: 100
فنقول: لو كان المتكلم من فعل الكلام، لكان لا يعلم المتكلم متكلما من يعلمه فاعلا للكلام، و ليس الأمر كذلك. فإن من سمع كلاما صادرا من متكلم استيقن كونه متكلما، من غير أن يخطر بباله كونه فاعلا لكلامه أو مضطرا إليه، فإذا اعتقد كونه متكلما مع الإضراب عن هذه الجهالات، تقرر بذلك أن كون المتكلم متكلما ليس معناه كونه فاعلا للكلام. و الذي يوضح ذلك أنا نعتقد أن لا فاعل على الحقيقة إلا اللّه تعالى، و نصمم على هذا الاعتقاد، و لا يزعنا عن العلم الضروري بكون المتكلم متكلما.
و مما يقوي التمسك به أن نقول: الكلام عندكم أصوات متقطعة و حروف منتظمة ضربا من الانتظام؛ فإذا قال القائل منا: قد قمت اليوم إلى زيد، فهذا الصادر منه كلامه و هو المتكلم به. فلو خلق اللّه تعالى هذه الأصوات على انتظامها في العبد ضرورة فلا يخلو المخالف، و قد فرضنا الكلام في ذلك؛ إما أن يقضي بكون محل الكلام متكلما، و إما أن لا يقضي به. فإن زعم أن المحل هو المتكلم فقد نقض المصير إلى أن المتكلم من فعل الكلام، فإن الكلام من فعل اللّه في الصورة المفروضة؛ و إن زعم أن محل الكلام أو الجملة التي محل الكلام منها ليست بمتكلمة، فقد عاند و جحد ما يداني البداية؛ فإنا نسمع من قام به الكلام يقول: قد قمت اليوم إلى زيد، كما كنا نسمعه يقول ذلك، إذ هو مختار.
ص: 101
و لو بنينا غرضنا من هذا الفصل على أصلنا في استبداد الرب سبحانه بالخلق، و استحالة كون غيره موجدا؛ فيتضح على هذا الأصل بطلان المصير إلى أن الباري تعالى إنما كان متكلما من حيث كان فاعلا للكلام، إذ هو فاعل كلام المحدثين و ليس متكلما به.
و يتضح الإلزام على البخارية: فإنهم يوافقون أهل الحق في أن الرب تعالى خالق أعمال العباد، فلا يستمر لهم، و هذا معتقدهم، القول بأن المتكلم من فعل الكلام. ثم الكلام على مذهب المخالفين أصوات، فلئن كان المتكلم من فعل الكلام، فليكن المصوت من فعل الصوت. و يلزم من سياق ذلك كون الباري تعالى عن قول الزائغين، مصوتا من حيث كان فاعلا للصوت.
و إذا بطل بهذه القواطع مذهب من يقول المتكلم من فعل الكلام فلا بد من اختصاص الكلام بالمتكلم على وجه من الوجوه. فإذا انتقض وجه الفعل فلا يبقى على السبر و التقسيم، بعد بطلان ما ذكرناه إلا ما ارتضيناه من أن المتكلم من قام به الكلام. ثم ثبوت هذا الأصل يفضي إلى أن الكلام يوجب حكما لمحله و هو كونه متكلما؛ فإن كل صفة قامت بمحل أوجبت له حكما.
فهذه مقدمات كافية لغرضنا في الرد على المخالفين: ثم نوجه عليهم طلبات قبل الخوض في مقصود المسألة، تقول: الكلام في تفاصيل «الكلام» فرع
ص: 102
لثبوت كون الباري تعالى متكلما، فبم ينكرون على من يزعم أنه ليس بمتكلم أصلا؟.
فإن زعموا أن المتكلم: من فعل الكلام، و الباري سبحانه و تعالى مقتدر على خلق الكلام و إبداعه.
قلنا: قد أبطلنا عليكم ذهابكم إلى أن المتكلم: من فعل الكلام بالطرق المتقدمة؛ ثم ما ذكرتموه اكتفاء منكم بأن الكلام مقدور للباري، فلم زعمتم أن مقدوره قد وقع، و ليس كل ما يقضي العقل بكونه مقدرا للباري تعالى يجب كونه واقعا، إذ ذاك يؤدي إلى وقوع ما لا يتناهى من الحوادث من حيث كانت المقدورات غير متناهية؟
فإن قالوا: إنما عرفنا وقوع الكلام، و اتصافه تعالى بكونه متكلما، بالمعجزات، و الآيات الخارقة للعادات، الدالة على صدق مدعي النبوّات؛ ثم الأنبياء أخبروا عن كلام اللّه تعالى و وقوعه، و هم: المصدقون و المؤيدون بالآيات المحققة، و البراهين المصدقة؛ و عضدوا كلامهم هذا بأن قالوا: قد أسندتم العلم بنفي النقائص إلى السمع، ثم بنيتم إثبات كلام اللّه تعالى على المعجزات، فبم تنكرون على من يسلك مسلككم في ذلك؟ قلنا: خصومنا من المعتزلة، و من انتحى نحوهم،مصدودون أولا عن إثبات المعجزات، و التوصل إلى العلم بوجوهها، الدالة على صدق المتحدين بها، على ما سنذكر ذلك، إن شاء اللّه تعالى في المعجزات.
ص: 103
ثم نقول: لا يستمرّ لكم ما استمرّ لنا؛ فإذا قلنا عند محاولة إثبات ما رمناه من تصديق الملك، و تصدره بمنصبه في موعد معلوم، و قد احتفّ به المختصون بخدمته، من حاشيته، ثم ادّعى من جملة الحاضرين مدّع أنه رسول الملك إلى من شهد و غاب، و ذلك بمرأى من الملك و مسمع، و استشهد في هذه الحالة على إثبات الرسالة، بأمر يصدر من الملك، خارق للمألوف من عادته، فأجابه الملك إلى مناه و وافق دعواه، فيدل ذلك على تصديق الملك إياه بقوله في نفسه، و الفعل الظاهر مترجم عنه، نازل منزلة العبارات المصطلح عليها في إفهام المعاني.
فهذه سبيلنا، و لا يستتب ذلك للمعتزلة، فإن المعنى بكون الباري تعالى متكلما عندهم، أنه فاعل الكلام. و ليس في ظهور الآيات ما يدلّ على أنّ الباري تعالى خلق أصواتا متقطعة في بعض الأجسام، و هي الكلام، و إنما ترتبط المعجزات بتصديق مظهرها، إذا كان التصديق صفته، و كان المصدّق متصفا به على التحقيق، و ليس ترجع من الفعل صفة حقيقية إلى الفاعل، فلا تكون المعجزات دالة على ثبوت الكلام.
و الذي يوضح غرضنا في ذلك، أنا بينا بالبراهين أن المصدق لا يكون مصدقا لفعله التصديق، إذ التصديق من أقسام الكلام.
و قد ذكرنا عموما بطلان مذهب من يقول: المتكلم من فعل الكلام، و ذلك يحتوي على التصديق، فإنه من الكلام.
ص: 104
فإذا بطل كون الباري تعالى مصدقا للرسل بقول على مذاهب المعتزلة، و وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياء و نزولها منزلة التصديق بالقول فعند ذلك يتضح بطلان وجه دلالة المعجزات على فساد عقائدهم و متناقض قواعدهم، و في بطلان المعجزات انحسام السبيل المفضية بسالكها إلى إثبات القول، و كذلك يفعل اللّه بكل جاحد مرتاب، فهذه طلبة عليهم قبل الخوض في مقصود المسألة.
و مما يطالبون به أن نقول: بم تنكرون على من يزعم أنه تعالى متكلم لنفسه، كما أنه عندكم حيّ، عالم، قادر لنفسه، و يلزمون ذلك في كونه تعالى مريدا لنفسه؟ فإن قالوا: يمتنع كونه تعالى مريدا، متكلما لنفسه، من حيث أن الصفة الثابتة للنفس يجب أن يعم تعلقها إذا كانت متعلقة بسائر المتعلقات، و لذلك وجب كونه عالما بكل المعلومات، إذ كان عالما لنفسه، و هذا الذي ذكروه دعوى عريّة. و للمطالب أن يقول: إن الرّبّ تعالى مريد لنفسه لبعض المرادات دون بعض، و هذا بمثابة الاختصاص للإرادة الحادثة بمتعلقها.
فلو قال قائل: لم اختصت الإرادة بمتعلقها، و هلا تعدته إلى ما عداه؟ فمن جواب المحققين أن كل متعلق بمتعلق مختص به، لا يعلل اختصاصه، و إنما اختص لنفسه كما تعلق لنفسه، و ليس يسلم لهم أن الدالّ على كون الإله عالما بكل معلوم، كونه عالما لنفسه، و إنما الدال عليه وجه آخر.
ص: 105
و لا محيص من هذه الطّلبة. على أنهم نقضوا ما أسّسوا، حيث قالوا: الباري تعالى قادر لنفسه، ثم زعموا أن كونه قادرا لا يتعلق بجميع المقدورات، فإن مقدورات العباد ليست مقدورة للباري عندهم، تعالى اللّه عن قولهم؛ فهذه صفة نفسية على زعمهم خصّصوها.
فإن قالوا: الكلام حروف منتظمة، و أصوات متقطعة، فلا وجه لثبوت التكلم، صادرا عن النفس؛ و هذا الذي ذكروه تعويل منهم على ما تقرر الفراغ من إبطاله، إذ قد أثبتنا كلاما قائما بالنفس، ليس من قبيل الحروف و الأصوات و الألحان و النغمات. فهذا القدر مقصدنا من تقديم هذه الطّلبات.
و اعلموا بعدها أن الكلام مع المعتزلة، و سائر المخالفين في هذه المسألة، يتعلق بالنفي و الإثبات، فإن ما أثبتوه و قدروه كلاما، فهو في نفسه ثابت، و قولهم: إنه كلام اللّه تعالى، إذ ردّ إلى التحصيل آل الكلام إلى اللغات و التسميات؛ فإن معنى قولهم: «هذه العبارات كلام اللّه» أنها خلقه، و نحن لا ننكر أنها خلق اللّه، و لكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما به؛ فقد أطبقنا على المعنى، و تنازعنا بعد الاتفاق في تسميته.
و الكلام الذي يقضي أهل الحق بقدمه، هو الكلام القائم بالنفس، و المخالفون ينكرون أصله و لا يثبتونه، فتنازعوا بعد إثباته في حدثه أو قدمه.
ص: 106
فإذا تعرّضنا للحجاج، كان مساقه إثبات موجود نفوا أصله، فنقول: قد ثبت كون الباري تعالى متكلما بكلام، و العقول تقضي باختصاص كلامه به من وجه من الوجوه. و لا حاجة لتكلف إثبات ذلك بالدليل.
ثم لا يخلو الاختصاص المتفق عليه مذهبا المقضى به عقلا: إما أن يكون من حيث كان فعلا للباري، و إما أن يكون من حيث يختص بصفة أخرى من صفاته النفسية، أو المعنوية. و قد بطل المصير إلى أن الاختصاص وقوع الكلام فعلا للّه تعالى؛ فإنا قد أوضحنا بما قدمناه وجه الرّدّ على القائلين بأنّ المتكلم من فعل الكلام.
و يبطل تغيير الاختصاص بكون الكلام متعلقا بعلم اللّه و إرادته أو سمعه، أو بصره، فإن هذه الوجوه تتحقق في كلام العباد، مع اختصاصهم بالاتصاف به.
و لا يستقيم أن يقال: إن الكلام مختص على وجه بصفة نفسية للباري تعالى، فإن ذلك إجمال، لا ادّعاء الاختصاص، و نحن في محاولة إيضاحه على التفصيل، فقول القائل: الكلام مختص به، أو بصفة من صفات نفسه على الإجمال، من غير تعرض، لتبيين وجه الاختصاص، لا يتحصّل.
فإذا بطل صرف الاختصاص إلى الجهات المذكورة، لم يبق بعدها إلا القطع بأن كلام الباري سبحانه و تعالى يختص به اختصاص القيام، و إذا تقرر ذلك ترتبت عليه استحالة كونه حادثا بقيام الدليل على استحالة قبوله للحوادث، و لا يبقى بعد بطلان هذه الأقسام إلا مذهب أهل الحق في وصف الباري تعالى
ص: 107
بكونه متكلما بكلام قديم أزلي. و في طرق الحجاج العقلية متسع، و فيما ذكرناه مقنع.
فمما عولوا عليه أن قالوا: إذا أثبتم كلاما أزليّا، لم يخل بعد ذلك من أمرين؛ إما أن تقضوا بكون الكلام الأزلي أمرا، نهيا، إخبارا؛ و إما ألا تقضوا بذلك.
فإن زعمتم أنه كان في الأزل أمرا، نهيا، إخبارا، فقد أحلتم؛ فإن من حكم الأمر و النهي، أن يصادفا مأمورا و منهيا، و لم يكن في الأزل مخاطب متعرض، لأن يحثّ على أمر، و يزجر عن آخر، و ليس يعقل أمر لا مأمور له، و يستحيل كون المستحيل مأمورا.
و إن زعمتم أن الكلام في الأزل لم يكن موصوفا بأحكام أوصاف الكلام، فقد ذهبتم إلى ما لا يعقل. و الكلام على المذهب، ردّا أو قبولا، فرع لكونه معقولا. قلنا: قد ذهب عبد اللّه بن سعيد بن كلّاب (1)رحمه اللّه من أصحابنا إلى أن الكلام الأزلي لا يتصف بكونه أمرا، نهيا، خبرا، إلا عند وجود المخاطبين و استجماعهم شرائط المأمورين المنهيين.
فإذا أبدع اللّه العباد، و أفهمهم كلامه على قضية أمر، أو موجب زجر، أو مقتضى خبر، اتصف عند ذلك الكلام بهذه الأحكام، و هي من صفات الأفعال
ص: 108
عنده، بمثابة اتصاف الباري تعالى فيما لا يزال بكونه خالقا رازقا محسنا متفضلا.
و هذه الطريقة و إن درأت تشغيبا فهي غير مرضية. و الصحيح ما ارتضاه شيخنا رضي اللّه عنه من أن الكلام الأزلي لم يزل متصفا بكونه أمرا نهيا خبرا، و المعدوم على أصله، مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود، و الأمر القديم في نفسه على صفة الاقتضاء، ممن سيكون إذا كانوا. و الذي استنكروه من استحالة كون المعدوم مأمورا لا تحصيل له.
و الوجه أولا معارضتهم بأصل لهم يصدهم عن هذا الإلزام. و ذلك أن مذهبهم أن المأمور به معدوم، و إذا توجه الأمر على العبد بفعل، فالفعل قبل وجوده مأمور به. و إذا وجد، خرج عن كونه مأمورا به في حال حدوثه، كما خرج إذ ذاك عن كونه مقدورا على أصلهم، و ليس بين النفي و الإثبات رتبة. فإذا لم يكن الفعل الثابت مأمورا به، كان النفي مأمورا به متعلقا بالأمر؛ فإذا لم يبعدوا مأمورا به معدوما، لم يستقم منهم استبعاد مأمور معدوم.
و ما ذكروه أبعد؛ فإنا نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود، و إذا وجد تحقق كونه مأمورا، و نمنع تقدير معدومه علم الباري تعالى أنه لا يوجد مأمورا و يستحيل وجوده مأمورا، فما كان كذلك لم يتعلق به أمر التكليف. و المعتزلة قضوا بأن المعدوم مأمور به، و هو يخرج عند الوجود عن كونه مأمورا به. و هذا تمحيص منهم لتعلق العلم بالعدم.
ص: 109
ثم نقول: قد اتفق المسلمون قاطبة على أننا في وقتنا مأمورون بأمر اللّه، و مذهب جماهير المعتزلة أنه ليس للرب تعالى في وقتنا كلام، و أن ما وجد من كلامه، قد عدم؛ فإذا لم يستبعدوا كوننا مأمورين، و لا أمر، لم يبق لهم مضطرب فيما ذكروه.
ثم الرب سبحانه في أزله كان قادرا، و من حكم كون القادر قادرا أن يكون له مقدور، و المقدور هو الجائز الممكن، و إيقاع الأفعال في الأزل مستحيل متناقض. فإذا لم يبعد كونه قادرا أزلا، مع اختصاص وقوع المقدور بما لا يزال، لم يبعد أن يتصف بكلام هو اقتضاء ممن سيكون.
و مما يستروحون إليه أن قالوا: قد أجمع المسلمون قبل ظهور هذا الخلاف على أن القرآن كلام اللّه سبحانه، و اتفقوا على أنه سور و آيات و حروف منتظمة و كلمات، و هي مسموعة على التحقيق و لها مفتتح و مختتم. و هي معجزة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم، و الآية على صدقه، و المعجزة لا تكون إلا فعلا خارقا للعادة، واقعا على حسب تحدي النبي صلى اللّه عليه و سلّم. و يستحيل أن يكون القديم معجزا، إذ لا اختصاص للصفة الأزلية ببعض المتحدين دون بعض؛ و لو جاز تقدير كلام قديم قائم بالنفس أزلي معجزا، لجاز تقدير العلم القديم عند مثبتيه معجزا.
و هذا الذي ذكروه تخيلات لا تحصيل لها. فأما تشغيبهم بأن القرآن في إجماع المسلمين سور و آيات، و لها أوائل و فواصل و مطالع و مقاطع؛ فنقول لهم: أولا، مذهب جماهيركم أنه كلام اللّه تعالى إذ خلقه كان أصواتا، ثم تصرمت و انقضت، و المتلوّ المحفوظ المكتوب ليس بكلام اللّه، و هذا مذهب كل من
ص: 110
يتحذق من متأخريهم. و المصير إلى نفي كلام اللّه تعالى، أبشع و أشنع من المماراة في صفة الكلام.
و لما استشعر الجبائي ذلك، و أيقن أنه يلزم لو قال بهذا المذهب خرق إجماع الأمة، أبدع مذهبا خرق به حجاب الهيبة و ركب جحد الضرورات، و قال كلام اللّه تعالى يوجد مع قراءة كل قارئ. ثم الكلام عنده حروف تقارن الأصوات المتقطعة على مخارج الحروف، و ليست هي أصواتا، و زعم أنها توجد عند الكتابة؛ فإذا اتسقت الحروف المنظومة، و الرسوم المرقومة، وجدت حروف قائمة بالمصحف ليست الأشكال البادية و الأسطر الظاهرة. ثم زعم أن الحروف تسمع عند القراءة و إن لم تكن أصواتا، و لا ترى عند ثبوت الأسطر.
و قال أيضا: من قرأ كلام اللّه تعالى تثبت مع لهواته حروف هي قراءته، و هي مغايرة للأصوات، و حروف هي كلام اللّه و هي مغايرة للقراءة و الأصوات، و إذا أضرب القارئ عن القراءة عدم عنه كلام اللّه تعالى و هو بعينه موجود قائم بغيره.
و من شنيع مذهبه أنه قال: إذا اجتمع طائفة من القراء على تلاوة آية فيوجد بكل واحد منهم كلام اللّه، و الموجود بالكل كلام واحد. و نفس نقل هذا المذهب يغني اللبيب عن تكلف الرد عليهم.
و أما تحكمه بإثبات حروف مغايرة للأصوات، فخروج عن قضية العقل و إبداع مذهب لا شاهد له، و الحروف في تعارف العقلاء أنفس الأصوات
ص: 111
المتقطعة. ثم إذا ساغ ادعاء إدراك ما ليس بصوت عند صوت، فما المانع من ادعاء رؤية الحروف عند انتظام الرسوم و اتساق الرقوم في الأسطر المثبتة؟
و أما المصير إلى قيام الكلام الواحد بمحال فجحد للضرورة، و لا يستريب فيه محصل، و هذا المعتقد لا يسع استقصاء الرد عليه.
و من فضائح مذهبه، مصيره إلى أن العبد يلجئ الرب إلى خلق الكلام عند إيثاره اختراع الأصوات و النغمات. و هذه فضائح بادية لا يبوح بها عاقل.
ثم نقول بعد معارضتهم: قد زعمتم أن القرآن كلام اللّه، و إذا روجعتم في معنى إضافة الكلام إلى الباري تعالى لم تبدوا وجها في الاختصاص سوى كونه فعلا له، و الذي زعمتم أنه فعله فأنتم مساعدون عليه من مذهبنا، و هو أقصى غرضكم بإضافة الكلام إلى اللّه تعالى. فقد تساوت الأقدام في إضافة الكلام إلى اللّه تعالى و بقي تنازع في تسميات و إطلاقات، و ليس من البعيد عندنا إضافة فعل اللّه تعالى إليه إذا استقر الشرع على الإذن فيه، و هذا يدرأ عنا جميع ما شغبوا به.
ثم، القرآن قد يحمل على القراءة، و يقدّر مصدرا لقرأ، و يشهد لذلك قول القائل، و هو حسان بن ثابت يمدح عثمان رضي اللّه عنه:
ضحوا بأشمط عنوان السجود به ***يقطع الليل تسبيحا و قرآنا
ص: 112
معناه يقطع الليل تسبيحا و قراءة. و قد سمى الرب تعالى الصلاة قرآنا لاشتمالها على القراءة، فقال عزا اسمه: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً [سورة الإسراء: 78]. و معناه أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل و النهار صاعدين و هابطين. و في مأثور الأخبار أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم قال: «ما أذن اللّه لشي ء إذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن»(1) معناه حسن الترنم بالقراءة.
و أما ما ذكروه من إجماع المسلمين على كون القرآن معجزة للرسول(2)، مع القطع بانحصار المعجزات في الأفعال الخارقة للعادة، فنقول لهم: أولا، من أصلكم أن ما تحدى به النبي عليه السلام العرب، و هم اللّسن الفصحاء و اللّدّ البلغاء، لم يكن كلام اللّه تعالى، و ما خلقه الرب تعالى لنفسه كان إذ ذاك منقضيا، و إنما تحدى الرسول عليه السّلام بمثله، فأنتم أحق بمراغمة الإطباق من خصومكم من هذا الوجه، و من تصريحكم بأن كل قارئ آت بمثل كلام اللّه تعالى؛ فالرب عز اسمه قال: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ [سورة الإسراء: 88].
ثم ما يدلون به هم عليه مساعدون و مساهمون؛ فإنهم زعموا أن كلام اللّه معجزة للرسول عليه السلام، و عنوا بكلام اللّه كلاما فعله؛ و نحن نقول:
ص: 113
الكلام الذي فعله معجزة للرسول عليه السلام؛ فلم يبق لهم اختصاص في المعنى، و اضمحلّ جميع ما موهوا به.
و مما يشغبون به و يستذلّون به العوام، أن قالوا قوله تعالى: فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ [سورة طه: 12] كلام اللّه تعالى، و تقدير الاتصاف به في الأزل قبل خلق موسى عليه السلام هجر و خلف من الكلام.
و الوجه إذا تمسكوا بذلك، أن يقال لهم: «اخلع نعليك» في إجماع المسلمين كلام اللّه تعالى في دهرنا، و موسى غير مخاطب الآن، فإن لم يبعد ذلك متأخرا لم يبعد متقدما.
ثم التحقيق في ذلك أن المخالفين قدروا الكلام حروفا و أصواتا، و بنوا على ما اعتقدوه استحالة مخاطبة المعدوم بحروف تتوالى، و ليس الأمر على ما قدروه. فإن الكلام عند أهل الحق معنى قائم بالنفس ليس بحرف و لا صوت، و الكلام الأزلي يتعلق بجميع متعلقات الكلام على اتحاده، و هو أمر بالمأمورات، نهى عن المنهيات، خبر عن المخبرات، ثم يتعلق بالمتعلقات المتجددات و لا يتجدد في نفسه.
و سبيله فيما قررناه سبيل العلم الأزلي، فإنه كان في الأزل متعلقا بالقديم و صفاته و عدم العالم و أنه سيكون فيما لا يزال، و لما حدث العالم تعلق العلم الأزلي بوقوع حدوثه و لم يتجدد في نفسه.
و كذلك الكلام الأزلي كان على تقدير خطاب موسى إذا وجد، فلما وجد كان خطابا له تحقيقا، و المتجدد موسى دون الكلام.
ص: 114
و ربما يقولون: إنما يتكلم بالرد و القبول على المذهب المعقول، و الذي أثبتموه قائما بالنفس غير معقول فنتكلم عليه. و الوجه إذا سلكوا هذا المسلك، أن نقول: من أمر عبده وجد في نفسه اقتضاء الطاعة منه و دعاءه إلى الامتثال، و منكر ذلك جاحد للضرورة؛ فهذا الذي قضت به العقول هو الكلام القائم بالنفس عندنا، و هو مفهوم معلوم. فإن هم صرفوا الاقتضاء إلى مصرف آخر سوى ما ادعيناه، كان ذلك خبطا منهم في الجدال، و قد قدمنا في أدلتنا ما يوضح صرف الاقتضاء إلى ما رمينا إليه. و فيما أبديناه الآن ردع لتشغيبهم بدعوى الجهالة.
ذهبت الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن كلام اللّه تعالى قديم أزلي، ثم زعموا أنه حروف و أصوات، و قطعوا بأن المسموع من أصوات القراء و نغماتهم عين كلام اللّه تعالى، و أطلق الرعاع منهم القول بأن المسموع صوت اللّه تعالى، و هذا قياس جهالاتهم.
ثم قالوا: إذا كتب كلام اللّه تعالى بجسم من الأجسام، و انتظمت تلك الأجسام رسوما و رقوما، و أسطرا و كلاما، فهي بأعيانها كلام اللّه تعالى القديم، و قد كان إذ ذاك جسما حادثا، ثم انقلب قديما.
و قضوا بأن المرئي من الأسطر الكلام القديم، الذي هو حرف و صوت.
ص: 115
و أصلهم أن الأصوات، على تقطّعها و تواليها، كانت ثابتة في الأزل، قائمة بذات الباري، تعالى اللّه عن قولهم علوّا كبيرا. و قواعد مذهبهم مبنية على جحد الضرورات؛ فإنهم أثبتوا للكلام القديم على زعمهم ابتداء و انتهاء، و جعلوا منه سابقا و مسبوقا، فإن الحرف الثاني من كل كلمة مسبوق بالمتقدم عليه، و كل مسبوق مبتدأ وجوده، و باضطرار نعلم كون المفتتح وجوده حادثا.
و لا خفاء بمراغمتهم لبديهة العقول في حكمهم، بانقلاب الحادث قديما.
و مما يقرر افتضاحهم في مناكرة الحقائق، أن الحروف لو مثّلت من بعض الجواهر فهي عين كلام اللّه تعالى عندهم، و الحديد الذي صيغت منه الحروف خارج عن كونه حديدا، و نحن ندرك زبر الحديد متآلفة جسما، فكيف تسوغ محاجة قوم هذه غايتهم؟!
ثم جهلتهم يصممون على أن اسم اللّه إذا كتب، فالرقم المرئي في الكتابة هو الإله بعينه، و هو المعبود الذي يصمد إليه.
ثم أصلهم أن الكلام القديم يحل الأجسام و لا يفارق الذات، و هذا تلاعب بالدين، و انسلال عن ربقة المسلمين، و مضاهاة لنصّ مذهب النصارى في مصيرهم إلى قيام الكلمة بالمسيح، و تدرّعها بالناسوت. و لو لا اغترار كثير من العوام بالاعتزاء إلى هؤلاء، لاقتضى الحال الإضراب عن التعرض لهذه العورات البادية، و الفضائح المتمادية.
ص: 116
القراءة عند أهل الحق أصوات القراء و نغماتهم، و هي أكسابهم التي يؤمرون بها في حال إيجابا في بعض العبادات، و ندبا في كثير من الأوقات؛ و يزجرون عنها إذا أجنبوا، و يثابون عليها و يعاقبون على تركها، و هذا مما أجمع عليه المسلمون، و نطقت به الآثار، و دل عليه المستفيض من الأخبار.
و لا يتعلق الثواب و العقاب، إلا بما هو من اكتساب العباد. و يستحيل ارتباط التكليف و الترغيب و التعنيف بصفة أزلية، خارجة عن الممكنات و قبيل المقدورات.
و القراءة هي التي تستطاب من قارئ، و تستبشع من آخر، و هي الملحونة، و القويمة المستقيمة، و تتنزه عن كل ما ذكرناه الصفة القديمة؛ و لا يخطر لمن لازم الإنصاف أن الأصوات التي يبح لها حلقه، و تنتفخ على مستقرّ العادة منها أوداجه، و يقع على حسب الإيثار و الاختيار، محرفا، و قويما، و جهوريا، و خفيا نفس كلام اللّه تعالى، فهذا القول في
فأما المقروء بالقراءة فهو المفهوم منها المعلوم، و هو الكلام القديم الذي تدل عليه العبارات، و ليس منها.
ثم المقروء لا يحل القارى و لا يقوم به، و سبيل القراءة و المقروء كسبيل الذكر و المذكور.
ص: 117
و الذكر يرجع إلى أقوال الذاكرين، و الرّبّ المذكور المسبّح الممجّد، غير الذكر و التسبيح و التمجيد.
و العرب وضعت أنواع الدلالات على المدلولات بالعبارات؛ فسمت الإنباء عن الشعر إنشادا، و الإنباء عن الغائبات التي ليست من قبيل الكلام ذكرا، و سمت الدلالة على كلام اللّه تعالى بالأصوات قراءة.
كلام اللّه تعالى مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، و ليس حالّا في مصحف، و لا قائما بقلب. و الكتابة قد يعبر بها عن حركات الكاتب، و قد يعبر بها عن الحروف المرسومة، و الأسطر المرقومة، و كلها حوادث.
و مدلول الخطوط، و المفهوم منها الكلام القديم، و هذا بمثابة إطلاق القول بأن كلام اللّه تعالى مكتوب في المصاحف، و ليس المعنيّ بذلك اتصاله بالأجسام و قيامه بالأجرام.
و لم يصر أحد من المنتمين إلى التحقيق إلى قيام الكلام بمحل الأسطر، إلا الجبائي فيما حكينا من هذيانه. و يؤثر عن النجار أن الرقوم هي أجسام كلام اللّه تعالى، و الكلام أصوات عند القراءة، و أجسام عند الكتابة. و كل ذلك خبط و تخليط في بغية الحق، و تفريط في درك الصدق.
ص: 118
كلام اللّه تعالى مسموع في إطلاق المسلمين، و الشاهد لذلك من كتاب اللّه تعالى قوله تعالى:
وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ [سورة التوبة: 6].
ثم السماع لفظة محتملة، لا يتحد معناها، و لا ينفرد مقتضاها؛ فقد يراد بها الإدراك، و قد يراد بها الفهم و الإحاطة، و قد يراد بها الطاعة و الانقياد، و قد يراد بها الإجابة.
فأما السمع بمعنى الإدراك فمشهور لا خفاء به؛ و أما السمع بمعنى الفهم و العلم فشائع مذكور غير منكور.
و وصف اللّه تعالى المعاندين من الكفرة بكونهم صما؛ و ليس المراد اختلال حواسهم، و لكن المراد إعراضهم عن درك المعاني، و الإحاطة بما أنذروا به، و تدبر آيات اللّه تعالى.
و إذا حكى الحاكي كلام غيره على وجهه، فقد يقول السامع لأصوات المبلغ: قد سمعت كلام فلان، و هو يعني الغائب الذي أنهى إليه معنى كلامه.
و الذي يجب القطع به، أن المسموع المدرك في وقتنا الأصوات؛ فإذا سمي كلام اللّه تعالى مسموعا، فالمعنيّ به كونه مفهوما معلوما، عن أصوات مدركة و مسموعة. و الشاهد لذلك من القضايا الشرعية إجماع الأمة على أن الربّ
ص: 119
تعالى خصص موسى، و غيره من المصطفين من الإنس و الملائكة، بأن أسمعهم كلامه العزيز من غير واسطة.
فلو كان السامع لقراءة القارئ مدركا لنفس كلام اللّه تعالى، لما كان موسى صلوات اللّه عليه مخصصا بالتكليم، و إدراك كلام اللّه من غير تبليغ مبلغ و إنهاء مرسل.
كلام اللّه تعالى منزّل على الأنبياء، و قد دلّ على ذلك، آي كثيرة من الكتاب اللّه تعالى.
ثم ليس المعنى بالإنزال حط شي ء من علوّ إلى سفل؛ فإن الإنزال بمعنى الانتقال، يتخصص بالأجسام و الأجرام.
و من اعتقد قدم كلام اللّه تعالى، و قيامه بنفس الباري سبحانه و تعالى، و استحالة مزايلته للموصوف به، فلا يستريب في إحالة الانتقال عليه.
و من اعتقد حدث الكلام، و صار إلى أنه عرض من الأعراض، فلا يسوغ على معتقده أيضا تقدير الانتقال، إذ العرض لا يزول و لا ينتقل.
فالمعنيّ بالإنزال، أن جبريل صلوات اللّه عليه أدرك كلام اللّه تعالى و هو في مقامه فوق سبع سموات، ثم نزل إلى الأرض، فأفهم الرسول صلى اللّه عليه و سلّم ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام.
ص: 120
و إذا قال القائل: نزلت رسالة الملك إلى القصر، لم يرد بذلك انتقال أصواته، أو انتقال كلامه القائم بنفسه.
كلام اللّه تعالى واحد، و هو متعلق بجميع متعلقاته، و كذلك القول في سائر صفاته. و هو العالم بجميع المعلومات بعلم واحد، و القادر على جميع المقدورات بقدرة واحدة. و كذلك القول في الحياة و السمع و البصر و الإرادة.
و القضاء باتحاد الصفات ليس من مدارك العقول، بل هو مسند إلى قضية الشرع و موجب السمع. و ذلك أن إثبات العلم واحد مختلف فيه، و إنما يتوصل إلى إثباته على منكريه بالأدلة العقلية، و هذا في العلم الواحد. فأما تقدير علم ثان، فلم يثبته أحد من أهل الكلام المنتمين إلى الإسلام، فنفيه مجمع عليه مع اتصافه بالقدم.
فإن قال القائل: لئن استمر لكم ما ذكرتموه في العلم و القدرة، فما وجه تقريره في الإرادة و الكلام؟ قلنا: الغرض أن نوضح انعقاد الإجماع الواجب الاتباع على نفي كلام ثان قديم، و ذلك مقرر على ما ذكرناه لا خفاء به.
فإن قيل: ما الذي صرفكم عن مدارك العقول في هذه الفصول؟ قلنا: قد ألفينا العلم القديم متعلقا بالمعلومات، قائما مقام علوم مختلفة شاهدا، و ليس في العقل ما يفضي إلى القطع باستحالة قيام العلم القديم مقام القدرة، و ليس فيه أيضا ما يؤدي إلى وجوب تعلق العلم الواحد بجميع المعلومات، و كل ما
ص: 121
يحاول به إثبات ذلك من قضيات العقول باطل. و هذا المعتقد لا يحتمل استقصاء ما قيل فيه و الرد عليه.
قد امتنع مثبتو الصفات من تسميتها مغايرة للذات، و غرضنا من هذا الفصل يستدعي تقديم حقيقة الغيرين.
و الذي ارتضاه المتأخرون من أئمتنا في حقيقة الغيرين، أنهما الموجودان اللذان يجوز مفارقة أحدهما الثاني بزمان، أو مكان، أو وجود، أو عدم. و هذا أمثل من قول من قال: الغيران كل شيئين يجوز وجود أحدهما مع عدم الثاني؛ فإن معتقد قدم الجواهر و استحالة عدمها، يقطع بتغاير جسمين مع ذهوله عن تجويز عدم أحدهما، و لا يتحقق العلم بالمحقق دون درك الحقيقة.
و القول في إيضاح معنى الغيرين، ليس من القواطع عندي؛ إذ لا تدل عليه قضية عقلية، و لا دلالة قاطعة سمعية، و لسنا نقطع بإبطال قول من قال من المعتزلة: كل شيئين غيران. و الأمر يؤول إلى إطلاق ترجيح و تلويح متلّقى من ألفاظ محتملة.
فإن قيل: إذا لم تقطعوا بما ذكره أئمتكم في حقيقة الغيرين، فهل تقطعون بالمنع من إطلاق الغيرية في صفات الباري تعالى و ذاته؟ قلنا: هذا مما نمنع منه قطعا، لاتفاق الأمة على منع إطلاقه.
و كما لا توصف الصفات بأنها أغيار للذات، فلا يقال إنها هي. و لا نتحاشى من إطلاق القول بأن الصفات
ص: 122
موجودات، و العلم مع الذات موجودان، و كذلك القول في جميع الصفات. و امتنع الأئمة من تسمية الصفات مختلفة، و أطلق الإمام القاضي أبو بكر رضي اللّه عنه (1) القول بأنها مختلفة.
ذهب العلماء من أئمتنا إلى أن البقاء صفة الباقي زائدة على وجوده بمثابة العلم في حق العالم.
و الذي نرتضيه أن البقاء يرجع إلى نفس الوجود المستمر من غير مزيد؛ و لو لم نسلك هذا المسلك للزمنا أن نصف الصفات الأزلية بكونها باقية، ثم نثبت لها بقاء، و يجر سياق هذا القول إلى قيام المعنى بالمعنى. ثم لو قدرنا بقاء قديما، للزمنا أن نصفه ببقاء، ثم يتسلسل القول.
فإن قيل: الدليل على ثبوت المعاني تجدد أحكامها على محالها؛ فإذا وجدنا جوهرا غير متحرك، ثم اتصف بالتحرك، كان ذلك دالا على تجدد المعنى، و هذا بعينه متحقق في البقاء؛ فإن الجوهر في حال حدوثه لا يتصف بكونه باقيا، و إذا استمر له الوجود اتصف بكونه باقيا. قلنا:
الاتصاف بالبقاء راجع إلى استمرار الوجود، و هو بمثابة القدم؛ فما وجد و كان حديث عهد بالحدوث لم يسمّ قديما، فإذا عتق و تقادم سمي في الإطلاق قديما، و لا يدل ذلك على أن القدم معنى.
فإن قيل: إذا صرفتم البقاء إلى نفس الباقي، فما الذي تنكرون من قول من يقول ببقاء الأعراض؟ قلنا: الأعراض يستحيل بقاؤها، فإنها لو بقيت
ص: 123
لاستحال عدمها؛ فإنا إذا قدرنا بقاء بياض و دوام وجوده، لم يتصور انتفاؤه فيعقبه سواد؛ إذ ليس السواد بنفي البياض، و مضاداته أولى من البياض، بدفع السواد، و منعه من الطروّ.
و لا معنى لما يتخيله بعض الناس من أن الباقي يعدم بإعدام اللّه؛ فإن الإعدام هو العدم، و العدم نفي محض، و لا معنى لتعلق القدرة بالنفي المحض. و تحصيل قول القائل: يقدر الباري على إعدام الموجود يؤول إلى أنه يقدر على أن لا يكون الموجود.
فإن قيل: فما معنى عدم الجواهر؟ قلنا: الأعراض غير باقية، فإذا أراد اللّه عدم جوهر اقتطع عنه الأعراض بأن لا يخلقها فينعدم الجوهر إذ ذاك، إذ يستحيل وجود جوهر بلا عرض.
و المعتزلة نفوا البقاء، و زعموا أن معظم الأعراض باقية، و ما يعدم من الباقيات، فإنما يعدم بضدّ يطرأ عليه، و وافقونا في استحالة بقاء الأصوات و الإرادات في خبط طويل. و زعموا أن الجواهر تعدم، بأن يخلق اللّه تعالى فناء في غير محل يضاد الجوهر، و هو في نفسه عرض قائم بنفسه، ثم يستحيل عندهم فناء بعض الجواهر و بقاء بعضها.
التسمية ترجع عند أهل الحق إلى لفظ المسمى الدال على الاسم، و الاسم لا يرجع إلى لفظه، بل هو مدلول التسمية.
ص: 124
فإذا قال القائل: زيد، كان قوله تسمية، و كان المفهوم منه اسما، و الاسم هو المسمى في هذه الحالة، و الوصف و الصفة بمثابة التسمية و الاسم؛ فالوصف قول الواصف، و الصفة مدلول الوصف.
ثم قد يرد الاسم، و المراد به التسمية، و قد ترد الصفة، و المراد بها الوصف، و لا يبلغ الكلام في ذلك مبلغ القطع.
و ذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الاسم و التسمية، و الوصف و الصفة، و التزموا على ذلك بدعة شنعاء، فقالوا: لو لم تكن للباري في الأزل صفة و لا اسم، فإن الاسم و الصفة أقوال المسمين و الواصفين، و لم يكن في الأزل قول عندهم و من زعم أنه لم يكن لربه تعالى في أزله صفة الألوهية، فقد فارق الدين، و راغم إجماع المسلمين.
ثم الدليل على أن الاسم يفارق التسمية، و يراد به المسمى، آي من كتاب اللّه تعالى؛ منها قوله تعالى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى سورةالأعلى: 1، و انما المسبح وجود الباري تعالى دون ألفاظ الذاكرين و قال عزّ و جلّ: تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ [سورة الرحمن: 78]؛ و قال تعالى: ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ [سورة يوسف: 40].
و معلوم أن عبدة الأصنام ما عبدوا اللفظ و الكلام، و إنما عبدوا المسميات لا التسميات.
فإن قيل: أطلق المسلمون القول بأن للّه تعالى تسعة و تسعين اسما؛ فلو كان الاسم هو المسمى، لكان ذلك حكما بتعدد الآلهة.
ص: 125
و لنا في جواب ذلك مسلكان: أحدهما، أن نقول قد يراد بالاسم التسمية، و هذا مما لا ننكره، فيحمل الإطلاق في الأسماء على المسميات.
و الوجه الثاني، أن كل اسم دل على فعل فهو اسم، فالأسماء هي الأفعال، و هي متعدّدة؛ و ما دلّ على الصفات القديمة، لم يبعد فيه التعدد؛ و ما دل على الصفات النفسية، و هي الأحوال فلا يبعد أيضا تعددها.
ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء اللّه تعالى و صفاته أطلقناه؛ و ما منع الشرع من إطلاقه، منعناه، و ما لم يرد فيه إذن و لا منع لم نقض فيه بتحليل و لا تحريم؛ فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد السمع؛ و لو قضينا بتحليل أو تحريم من غير شرع، لكنا مثبتين حكما دون السمع.
ثم لا نشترط في جواز الإطلاق، ورود ما يقطع به في الشرع، و لكن ما يقتضي العمل- و إن لم يوجب العلم- فهو كاف. غير أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل، و لا يجوز التمسك بها في تسمية الرب و وصفه، فاعلم.
ص: 126
قسم شيخنا، رضي اللّه عنه، أسماء الرب سبحانه و تعالى ثلاثة أقسام. و قال من أسمائه ما نقول إنه هو هو، و هو كل ما دلت التسمية به على وجوده؛ و من أسمائه ما نقول إنه غيره، و هو كل ما دلت التسمية به على فعل كالخالق و الرازق؛ و من أسمائه ما لا يقال إنه هو و لا يقال إنه غيره، و هو كل ما دلت التسمية به على صفة قديمة كالعالم و القادر.
و ذكر بعض أئمتنا أن كل اسم هو المسمى بعينه، و صار إلى أن الرب سبحانه و تعالى إذا سمي خالقا فالخالق هو الاسم، و هو الرب تعالى؛ و ليس الخالق اسما للخلق، و لا الخلق اسما للخالق، و طرد ذلك في جميع الأقسام.
و المرتضى عندنا طريقة شيخنا رضي اللّه عنه؛ فإن الأسماء تتنزل منزلة الصفات، فإذا أطلقت و لم تقتض نفيا حملت على ثبوت متحقق. فإذا قلنا: اللّه الخالق، وجب صرف ذلك إلى ثبوت و هو الخلق، و كان معنى الخالق من له الخلق، و لا ترجع من الخلق صفة متحققة إلى الذات، فلا يدل الخالق إلا على إثبات الخلق. و لذلك قال أئمتنا: لا يتصف الباري تعالى في أزله بكونه خالقا، إذ لا خلق في الأزل، و لو وصف بذلك على معنى أنه قادر كان تجوزا. فخرج من ذلك أن العلم و القدرة كما كانا صفتين، فكذلك هما اسمان. و الكلام في ذلك يؤول إلى التنازع في إطلاق لفظ و منع إطلاقه.
ص: 127
ثم جميع أسماء الرب سبحانه تنقسم إلى ما يدل على الذات، أو يدل على الصفات القديمة، و إلى ما يدل على الأفعال، أو يدل على النفي فيما يتقدس الباري سبحانه عنه. و نحن الآن نشير إلى تفسير الأسماء المأثورة على إيجاز.
فأما «اللّه»، فالصحيح أنه بمثابة الاسم العلم للباري سبحانه، و لا اشتقاق له. ثم قيل: أصله إله، فزيدت اللام فيه تعظيما. و قيل: الإله، ثم حذفوا الهمزة المتخللة، و أدغموا اللام للتعظيم في التي تليها. و قيل: أصله لاه، فزيدت فيه اللام تعظيما. و قال بعض أهل اللغة: هو من التألّه، و هو التعبد، فاللّه معناه المقصود بالعبادة.
«الرحمن الرحيم»: هما اسمان مأخوذان من الرحمة، و معناهما واحد عند المحققين، كالنّدمان و النديم، و إن كان الرحمن يختص به اللّه تعالى و لا يوصف به غيره. ثم الرحمة مصروفة عند المحققين إلى إرادة الباري تعالى إنعاما على عبده، فيكون الاسمان من صفات الذات. و حمل بعض العلماء الرحمة على نفس الإنعام، فيعود الرحمن الرحيم إلى صفات الأفعال.
«الملك»: معناه ذو الملك. ثم اختلفوا في الملك؛ فمنهم من فسره بالخلق، فالملك الخالق و هو من أسماء الأفعال. و قال بعضهم: الملك القدرة على الاختراع؛ إذ يقال: فلان يملك الانتفاع بماله، معناه يتمكن منه، فيكون الاسم على ذلك من أسماء الصفات، و الرب تعالى لم يزل و لا يزال مالكا.
«القدّوس»: فعول من القدس و هو الطهارة و النزاهة، و معناه التنزيه من صفات النقص و دلالات الحدث، و هو من أسماء التنزيه و النفي. و سميت
ص: 128
الأرض المقدسة مقدسة، لأنها مبرأة من أوضار الجبابرة، و سميت الجنان حضرة القدس لذلك.
«السلام»: قيل معناه ذو السلامة من كل آفة و نقيصة، فيكون من أسماء التنزيه؛ و قيل معناه مالك تسليم العباد من المهالك و المعاطب، فيرجع إلى القدرة؛ و قيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنان، فيرجع إلى الكلام القديم و القول الأزلي، قال اللّه تعالى: سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ [سورة يس: 58].
«المؤمن»: قيل معناه المصدق؛ فإن الإيمان هو التصديق و الرب تعالى مصدق نفسه و رسله بقول الصدق، فالاسم راجع إلى الكلام؛ و قيل المؤمن معناه أنه تعالى يؤمن الأبرار من الفزع الأكبر، و على ذلك يحتمل صرف الاسم إلى القول، فإن الرب تعالى سيؤمن عباده يوم العرض الأكبر و يسمعهم قوله تعالى: أَلَّا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا [سورة فصلت: 30]، و يجوز صرف الاسم إلى القدرة على خلق الأمنة و الطمأنينة، فيكون من أسماء الأفعال.
«المهيمن»: قيل معناه الشاهد؛ ثم ينقسم معنى الشاهد فيمكن حمله على العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، و يمكن حمله على القول بمعنى أن الرب تعالى يشهد على كل نفس بما كسبت؛ قال الخليل في تفسير المهيمن: هو الرقيب، و سيأتي تفسير الرقيب؛ و قيل: معنى المهيمن أصله المؤيمن فقلبت الهمزة هاء على قياس قولهم: هرقت و أرقت في معنى، و هرجت في أرقت و أرجت؛ و المؤيمن معناه الأمين، و هو الصادق وعده.
ص: 129
«العزيز»: معناه الغالب، و الغلبة ترجع إلى القدرة؛ و من قول العرب: «من عزّ بزّ» معناه من غلب صلب، و الأرض الصّلبة تسمى عزازا لقوتها؛ و قيل: العزيز العديم المثل، فالاسم على ذلك يرجع إلى التنزيه.
«الجبّار»: معناه مقدر الصلاح، من قولهم: جبرت العظم الكسير فانجبر فهو من أسماء الأفعال إذا: و قيل: الجبار معناه حامل العباد على ما يريد، و يرجع الاسم إما إلى الفعل و إما إلى القدرة عليه؛ و قيل: الجبار معناه الذي لا يؤثر فيه قصد القاصدين و لا يناله كيد الكائدين. و النخلة إذا أرقلت و بسقت و فاتت الأيدي، قيل نخلة جبارة؛ فيقرب معنى الجبار من معنى المتعال على ما يأتي تفسيره.
«المتكبر»: معناه و معنى «العليّ»، و «المتعال»، و «العظيم» واحد. و من العلماء من حمل هذه الأسماء على التنزيه و التعالي و التقدس عن أمارات الحدث و سمات النقص. و من الأئمة من حمل هذه الأسماء على الاتصاف بجميع صفات الألوهية التي بها يخالف الرب خلقه، و يندرج تحت هذه الطريقة تضمنها للتنزيه، و هذا أحسن؛ و لا بعد في اشتمال الاسم الواحد على معان تنقسم إلى النفي و الإثبات.
«الخالق، البارئ، المصور»: أما الخالق فمعناه بيّن؛ و الخلق قد يراد به الاختراع و هو أظهر معانيه، و يراد به التقدير؛ و لذلك سمي الحذّاء خالقا، لتقديره بعض طاقات النعل على بعض.
و حمل المفسرون قوله تعالى: فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ [سورة المؤمنون: 14] على معنى التقدير.
و البارئ معناه الخالق؛ و المصوّر مبدع الصور.
ص: 130
«الغفار»: معناه الستار، و الغفر في اللغة الستر، و منه سمي المغفر مغفرا. ثم يمكن حمل الستر على ترك العقاب، و يمكن حمله على الإنعام الذي يدرأ عن العبد ما يفضحه في العاجل و الآجل.
«القهار»: ظاهر المعنى. و يمكن صرفه إلى القدرة، و لا يبعد صرفه إلى الأفعال التي تذل الجبابرة كالإهلاك و نحوه.
«الوهاب»: مانح النعم.
«الرزاق»: خالق الرزق و مبدع الإمتاع به، و سيأتي معنى الرزق.
«الفتاح»: قيل معناه الحاكم بين الخلائق، و الفتح الحكم في اللغة، و العرب تسمي الحاكم فتّاحا، و هو المعنيّ بقوله تعالى: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ [سورة الأعراف: 89] معناه ربنا احكم بيننا. و إذا حمل على الحاكم فيمكن صرفه إلى القول القديم، و يمكن صرفه إلى الأفعال المنصفة للمظلومين من الظالمين. و قيل: الفتاح، مبدع الفتح و النصر.
«العليم» معناه: العالم على مبالغة، و بناء فعيل من أبنية المبالغة.
«القابض، الباسط»: من صفات الأفعال؛ و القابض معناه: المضيق على من أراد؛ و الباسط، الموسع الأرزاق على من أراد.
«الخافض، الرافع»: من صفات الأفعال، و معناهما ظاهر.
و كذلك «المعز، المذل، السميع، البصير» ظاهر المعاني.
ص: 131
«الحكم» معناه: الحاكم، و يمكن صرفه إلى قول اللّه، المبين لكل نفس جزاء عملها، و يمكن صرفه إلى أفعال المجازاة في الثواب و العقاب.
و قيل: الحكم و الحاكم يرجعان إلى معنى المنع؛ و من ذلك سميت حكمة اللجام حكمة، فإنها تمنع الدابة من الجماح، و سميت العلوم حكما، لأنها تزع الموصوفين بها عن شيم الجاهلين.
«العدل» معناه: العادل، و هو الذي يفعل ما له فعله.
«اللطيف» قيل: الملطف، كالجميل، معناه المجمل، و هو إذا من صفات الأفعال. و قيل:
اللطيف، العليم بخفيات الأمور.
«الخبير» معناه: العليم.
«الحليم» معناه: الذي لا تستفزه زلات العصاة، و لا تحمله على استعجال عقوبتهم قبل آجالها، و يرجع معنى الاسم إلى التنزيه و التعالي عن الاتصاف بالعجلة. و قيل: الحليم العفوّ؛ و معناه ينقسم إما إلى الإنعام، و إما إلى ترك الانتقام، و الوجهان قريبان.
«الشكور»: معناه المجازي عباده على شكرهم إياه، فيكون الاسم من معنى الازدواج؛ و قيل: الشكور معطي الكثير على العمل القليل؛ و قيل: الشكور المثني على العباد المصطفين، فهذا إذا راجع إلى القول.
ص: 132
«الحفيظ»: قيل معناه العليم، و الحفظ العلم، و منه قول القائل: فلان يحفظ القرآن، معناه يعلمه؛ و قيل: الحفيظ الحافظ، و هو مدبر الخلائق و كالئهم عن المهالك.
«المقيت»: قيل معناه خالق الأقوات؛ و قيل معناه المقدر و مبدع كل شي ء على قدره؛ و قيل معناه القادر، و قال الشاعر:
و ذي ضغن كففت النفس عنه و كنت على إساءته مقيتا
معناه قادرا حتى إساءته.
«الحسيب»: قيل معناه الكافي، و العرب تقول: أعطيته فأحسبته، معناه جاملته إلى أن قال حسبي أي كفاني؛ و قيل الحسيب معناه محاسب الخلق، و يرجع الاسم إلى القول.
«الجليل» معناه: العظيم، و قد سبق تفسيره.
«الكريم» قيل معناه المفضل؛ و قيل معناه الغفور؛ و قيل معناه العليّ؛ و خزائن الأموال تسمى كرائم، و كل نفيس كريم.
«الرقيب» معناه: العليم الذي لا يعزب عنه شي ء.
«المجيب»: يرجع معناه إلى إجابة دعاء الداعين، و هو راجع إلى الكلام القديم، و يمكن حمله على الأفعال التي تقتضي إسعاف المحتاجين؛ يقال: أجبت فلانا إلى ملتمسه، إذا أسعفته به.
ص: 133
«الواسع»: قيل معناه العالم، و قيل معناه الجواد، فإن ذا الجود يوصف بسعة الصدر، و ينفي عنه ضيق العطن؛ و قيل معناه الغني و سيأتي تفسير الغني في باب التعديل.
«الحكيم»: قيل معناه العليم؛ و قيل معناه الحاكم، و قد مرّ تفسيره؛ و قيل معناه المحكم المتقن.
«الودود»: قيل معناه الوادّ، و تفسيره المحب لأوليائه، و سيأتي تفسير المحبة من اللّه إن شاء اللّه؛ و قيل الودود المودود.
«المجيد»، قال الزجاج(1): معناه الحسن الفعال و أصله من قولهم مجدت الماشية إذا صادفت روضة أنفا خصيبة، و أمجدها الراعي؛ و منه قول العرب: في كل شجر نار، و استمجد المرخ و العفار. و المرخ و العفار شجرتان تقدح العرب بهما؛ و استمجد معناه اشتمل على حظ كبير، فالمجيد على ذلك يقرب من الجواد. و الجواد يمكن حمله على المنعم، و يمكن حمله على المقتدر على الوجود و الإنعام، و يمكن حمل المجيد على الكريم، فإن المجد شائع بمعنى الكرم.
«الباعث»: ناشر الموتى يوم الحشر؛ و قيل معناه: باعث الرسل إلى الأمم.
«الوارث»: الباقي بعد فناء خلقه. «الشهيد»، قيل معناه: العليم كما سبق. «الحق»، قيل معناه: الواجب الوجود؛ و قيل معناه: المحق، و هو يقرب من صفات الأفعال على ذلك.
ص: 134
«الوكيل» معناه: القائم على خلقه بما يصلحهم، و قيل معناه: الموكول إليه تدبير البرية.
«القوي»، معناه: القادر؛ و قيل معناه المتين.
«الوليّ»، معناه: الناصر؛ و قيل: معناه: متولي أمر الخلائق.
«الحميد» معناه: المحمود. و حقيقة الحمد: الثناء.
«المحصي»، قيل معناه: العالم، المحيط بالمعلومات؛ و قيل معناه: القادر، و الوجهان ظاهران في اللغة.
«المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحيّ»: لا خفاء بمعانيها.
«القيّوم»، معناه: مدبر الخلائق في الحال و المآل، و هي من صفات الأفعال.
«الواجد»، قيل معناه: الغني من الوجد. قال اللّه تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [سورة الطلاق: 6].
«الماجد»: معناه: المجيد. «الواحد»، معناه: المتوحد. المتعالي عن الانقسام؛ و قيل معناه:
الذي لا مثيل له في ذاته و لا في صفاته و لا في أفعاله و لا في أسمائه، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا [سورة مريم: 65].
«الصمد»، قيل: هو السيد؛ و قيل في السيد إنه المالك، و قيل إنه الحليم. و فسر ابن عباس قوله تعالى في صفة يحيى عليه السلام: وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً [سورة آل عمران: 39] قال: معناه «حليما»؛ و قيل: الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج؛ و قيل الصمد الذي لا جوف له.
ص: 135
«القادر، المقتدر، المقدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر»: مفهومة المعنى.
«الظاهر، الباطن»؛ قيل الظاهر معناه القاهر، من قول القائل «ظهر فلان على فلان»؛ و قيل معناه المعلوم بالأدلة القاطعة.
«و الباطن» قيل: هو المحتجب عن خلقه بموانع أبدعها في أبصارهم؛ و قيل: العالم بالخفيات.
«البرّ»: خالق البرية. «التواب»: الذي يرجع إنعامه على من حل عقد إصراره من المذنبين، و رجع إلى التزام الطاعة، و التوبة و الرجوع.
«المقسط»: العادل؛ يقال أقسط إذا عدل، و قسط إذا جار.
«النور»: معناه: الهادي. «البديع»، قيل: هو المبدع؛ و قيل: هو الذي لا نظير له.
«الرشيد»: قيل: معناه المرشد؛ و قيل: هو العالم؛ و قيل: هو المتعالي عن الدنيات و سمات النقص.
«الصبور»: معناه الحليم، و قد سبق تفسيره.
ص: 136
ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين و العينين و الوجه صفات ثابتة للرب تعالى، و السبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل. و الذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة، و حمل العينين على البصر، و حمل الوجه على الوجود.
و من أثبت هذه الصفات السمعية و صار إلى أنها زائدة على ما دلت عليه دلالات العقول، استدل بقوله تعالى في توبيخ إبليس إذ امتنع عن السجود: ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [سورة ص: 75]. قالوا: و لا وجه لحمل اليدين على القدرة، إذ جملة المبدعات مخترعة للّه تعالى بالقدرة، ففي الحمل على ذلك إبطال فائدة التخصيص، و هذا غير سديد؛ فإن العقول قضت بأن الخلق لا يقع إلا بالقدرة، أو بكون القادر قادرا، فلا وجه لاعتقاد وقوع خلق آدم عليه السلام بغير القدرة.
و مما يوضح ما قلناه، أن آدم صلوات اللّه عليه ما استحق أن يسجد له لما خصص به من الخلق باليدين، و ذلك متفق عليه مقضى به في موجب العقل، و إنما لزم السجود اتباعا لأمر اللّه. فإذا وجب على كل محقق القطع بأن آدم عليه السلام لم يسجد له لأنه خلق باليدين، و ظاهر الآية يقتضي اقتضاء السجود لاختصاص آدم بما تضمنته الآية، فالظاهر متروك إذا و العقل حاكم بأن الذي يقع الخلق به القدرة.
ص: 137
ثم لا بعد في تكريم بعض العباد بالتخصيص بالذكر، و نظائر ذلك في كتاب اللّه كثيرة فإنه عز اسمه أضاف الكعبة إلى نفسه و لا اختصاص لها بذلك، و أضاف المؤمنين بصفة العبودية إلى نفسه، و أضاف روح عيسى عليه السلام إلى نفسه. و الإضافة تنقسم إلى إضافة صفة، و إضافة ملك، و إضافة تشريف.
فأما الآية المشتملة على ذكر العينين فمزالة الظاهر اتفاقا، و كذلك قوله تعالى في الإنباء عن سفينة نوح عليه السلام: تَجْرِي بِأَعْيُنِنا [سورة القمر: 14] و لم يثبت أحد من المنتمين إلى التحقيق أعينا للّه تعالى. و المعنى بالآية أنها تجري بأعيننا، و هي منا بالمكان المحوط بالملائكة و الحفظ و الرعاية؛ يقال فلان بمرأى من الملك و مسمع، إذ كان بحيث تحوطه عنايته و تكتنفه رعايته. و قيل المراد بالأعين في هذه الآية، الأعين التي انفجرت من الأرض، و أضيفت إلى اللّه تعالى ملكا، و هذا غير بعيد.
و أما قوله تعالى: وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ [سورة الرحمن: 27]، فلا وجه لحمل الوجه على صفة، إذ لا تختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفة للّه تعالى، بل هو الباقي بصفاته الواجبة، فالأظهر حمل الوجه على الوجود. و قيل المراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى اللّه تعالى؛ يقال: فعلت ذلك لوجه اللّه تعالى، معناه لجهة امتثال أمر اللّه. فالمعنى بالآية. أن كل ما لم يرد به وجه اللّه محبط.
و من سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر هذه الآيات، ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء و المجي ء و النزول و الجنب من الصفات
ص: 138
تمسكا بالظاهر. فإن ساغ تأويلها فيما يتفق عليه، لم يبعد أيضا طريق التأويل فيما ذكرناه.
و كنا على الإضراب عن الكلام على الظواهر، فإذا عرض فسنشير إلى جمل منها في الكتاب و السنة. و قد صرح بالاسترواح إليها الحشوية الرعاع المجسمة.
فمما يسأل عنه قوله تعالى: اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ [سورة النور: 35]، قيل معناه اللّه هادي أهل السموات و الأرض، و لا يستجيز منتم إلى الإسلام القول بأن نور السموات و الأرض هو الإله. و المقصود من الآية ضرب الأمثال فهي بذلك على الإجمال، و قد نطق بما ذكرناه سياق الآية، فإنه عز من قائل قال: وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ [سورة النور: 35].
و مما يسأل عنه قوله تعالى: يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ [سورة الزمر: 56]، و لا يلتبس معنى هذه الآية إلا على غر غبي. إذ لا يتجه في انتظام الكلام حمل الجنب على تقدير الجارحة، مع ذكر التفريط، فلا وجه إلا حمل الجنب على جهات أمر اللّه تعالى و مأخذها. و قد يراد بالجنب الجناب و الدّرا لعل المراد بها جمع ذروة؛ يقال فلان محترس برعاية فلان، لائذ إلى جنبه، عائذ بجنابه. و ليس ما ذكرنا من مضارب التأويل، بل على قطع نعلم بطلان حمل الجنب الذي أضيف إليه التفريط على الجارحة.
و مما يسأل عنه قوله تعالى: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ [سورة القلم: 42]، فالمعنى بالآية الإنباء عن أهوال يوم القيامة و صعوبة أحوالها، و ما يدفع إليه المجرمون من أنكالها. و إذا وجد الأمر في الحرب، و استعرت الصدور بالغيظ، و حدجت
ص: 139
الأعين بالبغضاء، و شمخت الأنوف، و التحمت المصارع، قيل: قامت الحرب على ساقها؛ و لا يتخيل حمل الساق على الجارحة ذو تحصيل.
و مما يسأل عنه قوله تعالى: وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا [سورة الفجر: 22]، و كذلك قوله تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ [سورة البقرة: 210]؛ و ليس المعنيّ بالمجي ء الانتقال و الزوال، تعالى اللّه عن ذلك؛ بل المعنيّ بقوله: «وَ جاءَ رَبُّكَ»، أي جاء أمر ربك و قضاؤه الفصل و حكمه العدل.
و من شائع الكلام التعبير عن الأمر بذي الأمر في إرادة التعظيم؛ إذ يقال: إذا جاء الأمير بطل من سواه، و ليس الغرض انتقاله، بل المراد اتصال نوافذ أوامره و زواجره. و إذا كان للتأويل مجال رحب، و للإمكان مجرى سهب، فلا معنى لحمل الآية على ما يقتضي تثبيت دلالات الحدث.
و مما يجب الاعتناء به معارضة الحشوية بآيات يوافقون على تأويلها، حتى إذا سلكوا مسلك التأويل، عورضوا بذلك السبيل فيما فيه التنازع؛ فمما يعارضون به قوله تعالى: وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ [سورة الحديد: 4] فإن راموا إجراء ذلك على الظاهر، حلوا عقد إصرارهم في حمل الاستواء على العرش على الكون عليه، و التزموا فضائح لا يبوء بها عاقل. و إن حملوا قوله: «هو معكم أينما كنتم»، و قوله: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ [سورة المجادلة: 7]، على الإحاطة بالخفيات، فقد تسوغوا التأويل، و هذا القدر في ظواهر القرآن كاف.
ص: 140
و أما الأحاديث التي يتمسكون بها، فآحاد لا تفضي إلى العلم، و لو أضربنا عن جميعها لكان سائغا، لكنا نومئ إلى تأويل ما دون منها في الصحاح. فمنها حديث النزول، و هو ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «ينزل اللّه تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة جمعة و يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب له؟» «1» الحديث. و لا وجه لحمل النزول على التحول، و تفريغ مكان و شغل غيره، فإن ذلك من صفات الأجسام و نعوت الأجرام. و تجويز ذلك يؤدي إلى طرفي نقيض، أحدهما الحكم بحدوث الإله، و الثاني القدح في الدليل على حدوث الأجسام.
و الوجه حمل النزول، و إن كان مضافا إلى اللّه تعالى، على نزول ملائكته المقربين، و ذلك سائغ غير بعيد. و نظير ذلك قوله تعالى: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ [سورة المائدة: 33]، معناه إنما جزاء الذين يحاربون أولياء اللّه، و لا يبعد حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه تخصيصا.
و مما يتجه في تأويل الحديث أن يحمل النزول على إسباغ اللّه نعماءه على عباده مع تماديهم في العدوان و إصرارهم على العصيان، و ذهولهم في الليالي عن تدبر آيات اللّه تعالى، و تذكر ما هم بصدده من أمر الآخرة. و قد يطلق النزول في حق الواحد منا على إرادة التواضع؛ فيقال: نزل الملك عن كبريائه إلى الدرجة الدنيا، إذا حلم على رعيته، و انحط عن سطوته، مع تمكنه من تشديد الوطأة عليهم.
و من الدليل على أن النزول ليس من شرطه الانتقال، إطلاق النزول مضافا إلى القرآن، مع العلم باستحالة انتقال الكلام كما سبق.
ص: 141
و مما وقع السؤال عنه ما يروى عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «إذا كان يوم القيامة، و استقرّ أهل الجنان في النعيم، و أهل النار في الجحيم؛ و قالت النار: هل من مزيد؟، فيضع الجبار قدمه في النار، فتقول النار: قط قط» .
و هذا مما رواه محمد بن إسماعيل في كتاب التفسير من مسنده الصحيح.
و للتأويل أوسع مجال فيه، فيمكن أن يحمل الجبار على متجبر من العباد، و هو في معلوم اللّه من أعتى العتاة، و قد ألهمت النار ترقبّه، فهي لا تزال تستزيد حتى يستقرّ قدم ذلك الجبار فيها، فتقول النار عند ذلك: قط قط.
و قد ورد في مأثور الأخبار: أن أقدام الخلائق البرّ منهم و الفاجر تستقر على متن جهنم كأنها إهالة جامدة، فإذا وافت الأقدام عليها ازدردت النار أهلها، و لهي أعرف بهم من الوالدة بولدها.
و مصداق حمل الجبار على ما ذكرناه، ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «أهل النار كل متكبر جبار، جظّ، جعظريّ، جوّاظ» .
و يمكن حمل القدم على بعض الأمم المستوجبة للنار في علم اللّه تعالى، و تكون الإضافة في القدم بمعنى الملك.
و مما تتمسك به الحشوية، ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «إن اللّه خلق آدم على صورته»، و هذا الحديث غير مدوّن في الصحاح، و إن صح فقد نقل له سبب أغفله الحشوية، و هو ما روي أن رجلا كان يلطم عبدا له حسن الوجه، فنهاه صلى اللّه عليه و سلّم عن ذلك، و قال: «إن اللّه تعالى خلق آدم على صورته»، و الهاء راجعة على العبد المنهي عن ضربه. و يمكن صرف الهاء إلى
ص: 142
آدم نفسه، و معنى الحديث على ذلك أن اللّه تعالى خلق آدم بشرا سويا من غير والد و والدة.
و الغرض من الحديث: أنه عليه الصلاة و السلام لم يدر في أطوار الخلق، بل أبدعه اللّه على صورته.
و من أحاط بما ذكرناه، لم يصعب عليه مدرك تأويل ما يسأل عنه، بعد التثبّت و عدم الابتدار إلى تأويل كل ما يسأل عنه من مناكير الأخبار.
فهذا، رحمكم اللّه، كاف بالغ في إثبات العلوم بالصفات الواجبة المنقسمة إلى النفسية و المعنوية، و قد اندرج في خلل الكلام في هذا القسم، إيضاح ما يستحيل على اللّه تعالى.
فإذا انصرم هذان الركنان، لم يبق بعدهما إلا الكلام فيما يجوز على اللّه تعالى، و بنجاز ذلك يتصرم المعتقد، و باللَّه التوفيق.
هذا الباب ينقسم، و يتفنّن، و يندرج تحته أصول عظيمة الموقع.
و نحن نرى تصديره بإثبات جواز تعلق الرؤية باللَّه تعالى.
ص: 143
الأولى بنا تقديم فصول يتعلق بها احتجاج أهل الحق، و يستند إليها الانفصال عن شبه المخالفين؛ فمن أهمها: إثبات الإدراك شاهدا.
فالذي صار إليه أهل الحق و معظم المعتزلة أن المدرك شاهدا مدرك بإدراك، كما أن العالم شاهدا عالم بعلم. و ذهب ابن الجبائي و شيعته إلى نفي الإدراك شاهدا و غائبا. و المصير إلى أن المدرك هو الحي الذي لا آفة به.
و كل ما دل على إثبات الأعراض فهو دال على إثبات الإدراكات فإنا استدللنا على ثبوت العلم بتجدد حكمه، و هو كون العالم عالما، ثم سبرنا الدلالة و قسمناها على حسب ما سبق من سبيل التوصل إلى إثبات المعاني، فيجرّنا سياق الدليل إلى إثبات العلم بكون المدرك مدركا؛ و كما يتجدد كون العالم عالما شاهدا ثم لا يلزم ذلك غائبا فكذلك يتجدد كون المدرك مدركا.
و من حمل كون المدرك مدركا على كونه حيا و انتفاء الآفة عنه، لم يتجه له انفصال عن من يسلك هذا المسلك بعينه في العلوم و القدر و الإرادات؛ و إن حمل الإدراك على حصول بنية مخصوصة، لم يبعد حمل العلم أيضا على بنية مخصوصة. و الجملة المغنية عن التفصيل: أن نفي الإدراكات يطرّق القوادح إلى سبيل إثبات الأعراض.
ص: 144
و إذا ثبت الإدراك بما أشرنا إليه، فاعلموا أن الإدراك لا يفتقر إلى بنية مخصوصة، و هذا باطل من أوجه: أقربها أن الإدراك الواحد لا يقوم إلا بالجوهر الفرد، ثم لا أثر للجواهر المحيطة بمحل الإدراك في محل الإدراك؛ فإن كل جوهر مختص بحيزه موصوف بأعراضه، و لا يؤثر جوهر في جوهر.
و إنما تثبت أحكام الجواهر من أعراضها المختصة بها قياما، و كذلك لا يؤثر عرض قائم بجوهر في جوهر آخر.
فإذا ثبت بما ذكرناه أن الجواهر التي يقدر اجتماعها مع محل الإدراك غير مؤثرة فيه، و وجودها في حكمه كعدمها، فيفضي مجموع ذلك إلى القطع بنفي اشتراط بنية و تركيب على صفة مخصوصة، و ذلك قاطع في مقصودنا.
و مما يقوي التمسك به في نفي اشتراط البنية، أن الشرط حكمه أن يطرد شاهدا و غائبا، و لذلك قالت المعتزلة: لما كان كون الحيّ حيا شرطا في كونه عالما شاهدا لزم القضاء بمثل ذلك غائبا.
فيلزمهم على هذا الشرط أن نقول لهم: لو كان كون المدرك مدركا شاهدا مشروطا بكونه مبنيا، للزم من وصف الباري بكونه مدركا وصفه بكونه مبنيا، تعالى اللّه عن قول المبطلين.
و إذا ثبت الإدراك و تقرر عدم افتقاره إلى بنية، و جواز قيامه بالجوهر الفرد، فنبني على ذلك أصلا في إيضاح بطلان عصمة المعتزلة، و ذلك أنهم قالوا: لا يدرك المدرك بإدراك الرؤية، حتى ينبعث شعاع من ناظر الرائي و يتصل
ص: 145
بالمرئي؛ فإذا استد الشعاع و تحقق انبعاثه من الحاسة على المرئي، و استقرت قواعده عليها، و لاقى الطرف الأخير المرئي و لم ينب عنه، فيرى عند ذلك.
فإذا كان بين المرئي و الرائي حجاب كثيف يمنع الشعاع من النفوذ لم يره. فإذا بعدت المسافة، و صارت بحيث تنبو الأشعة و تبيد، فلا يرى البعيد، و إن أفرط قربه من الناظر، و امتنع من إفراط القرب انبعاث الشعاع لم ير أيضا؛ و لذلك لا يرى داخل الأجفان عندهم.
و حملوا رؤية الرائي نفسه عند النظر إلى جسم صقيل على ذلك، فقالوا: الأشعة تنبعث، فإذا لاقت جسما صقيلا، لم تتشبث فيه إذ لا تضرس للصقيل، فينعكس الشعاع إلى الناظر، و يتصل به، فيدرك إذ ذاك نفسه؛ و إذا انفرج الشعاع من الأحوال و غيره، لم يدرك المدرك على ما هو عليه لعدم امتداد الشعاع، في هذيان طويل لا يحتمل هذا المعتقد شرحه.
و كل ما هذوا به مبنيّ على انبعاث أشعة هي أجسام لطيفة مضيئة من حاسة البصر، و لا يجوز تقدير انبعاثها من غير بنية العين.
و إذا أبطلنا بما قدمناه افتقار الإدراك، و كون المدرك مدركا، إلى بنية، فذلك يتضمن إفساد ما رتبوه على البنية لا محالة.
ثم الشعاع أجسام عندهم في داخل العين تنبعث منها عند فتح الأجفان. فيقال لهم: ما الذي يوجب انبعاثها؟ و هلا استقرت في أحيازها؟ و ما الموجب لانقباضها و انبساطها؟ فإن زعموا أن في تلك الحاسة اعتمادات توجب دفع الأشعة، فذلك بناء على فاسد أصلهم في التولد و هم غير مساعدين عليه. ثم
ص: 146
عندهم أن الاعتمادات اللازمة تكون سفلية كاعتمادات الثقيل، و علوية، كاعتمادات لهيب النار إذا اضطرمت، فأما سائر الجهات فالاعتمادات فيها مجتلبة مكتسبة؛ و الناظر ليس بمجتلب اعتمادا على جهة، كما يجتلبه إذا حاول دفع ثقيل يمنة أو يسرة.
فإن قالوا: إنما ينبعث الشعاع بحركات الحدقة و الأجفان، فذلك محال، فإن من تصطلم أجفانه يرى إذا سكن حدقته، فإذا ثبت أنه ليس لانبعاث الأشعة موجب و إن عدّ من خلق اللّه، فيلزم أن يقدر جواز عدم خلقة، حتى يجوز أن يفتح الحي المدرك غير المئوف عينه و ترتفع الحواجز و لا يريد الرب تعالى انبعاث الشعاع و لا يرى إذ ذاك شيئا، و هو من أمحل المحال عند القوم.
و مما يصعب موقعه عليهم أن نقول: لئن كان الجوهر يرى لاتصال الشعاع به، فما بال لونه يرى و هو عرض، و قد رئي، و لا يجوز الاتصال بالأعراض.
فإن قالوا: إنما يرى ما يتصل به الشعاع، أو ما يقوم بما يتصل به الشعاع؛ فنقول: مفاد ذلك يلزمكم جواز رؤية الطعوم و الروائح، لأنها تقوم بما يتصل به الشعاع.
و نقول لهم أيضا: عندكم أن الجوهر الفرد لو مثل في سمت الشعاع لما رئي، و قد اتصل الشعاع على امتداده به، و لو قدرتنا انضمام جواهر إليه لما خصه من الشعاع إلا ما اتصل به إذا قدر فردا، و كل ذلك دال على بطلان انبعاث الأشعة من الناظر و اتصالها بالمرئيات.
ص: 147
و إذا استدلّ المخالفون، على ما اعتقدوه من انبعاث الأشعة من الناظر، و اتصالها بالمرئيات، بما قدمناه في صدر الفصل، و ما يستروحون إليه من ذكر القرب و البعد، و تعريج الأشعة و انعكاسها عن الأجسام الصقيلة، فليس في شي ء مما ذكروه مستروح.
و إيجاز الجواب عن جميع ما يتمثلون به، أن نقول؛ لم ادّعيتم حمل ثبوت الرؤية تارة و انتفائها أخرى، على ظنونكم في انبعاث الأشعة و اتصالها؟ و بم تردون قول من يقول: كل ما تنفونه و تثبتونه يرجع إلى استمرار العادات على قضية أرادها اللّه عليها، و سبيلها كسبيل استعقاب الأكل و الشرب، الشبع، و الرّيّ، و إن لم يكونا موجبين لهما؟ و لو انخرقت العادة الجارية، لجاز رؤية البعيد المفرط البعد، و القريب المتداني.
و يجوز أيضا رؤية ما وراء الحجاب، و إذا طولبوا بذلك لم يرجعوا إلا إلى استبعاد محض لا محصول له، و الوجه معارضتهم بكل ما يوافقون على أنه موجب العادات المستمرة.
الإدراكات خمسة: أحدها البصر المتعلق بقبيل المرئيات، و الثاني السمع المتعلق بالأصوات،و الثالث: الإدراك المتعلق بالرّوائح، و الرابع: الإدراك المتعلق بالطعوم، و الخامس؛ الإدراك المتعلق بالحرارة و البرودة و اللين و الخشونة. و الحاسة في اصطلاح المحققين هي الجارحة التي يقوم ببعضها الإدراك، و قد يعبر بالشمّ و اللمس و الذوق عن الإدراكات تجوزا.
ص: 148
و هذه العبارات منبئة عند المحصلين عن اتصالات بين الحواس و بين أجسام تدرك، و يدرك أعراض لها. و ليست الاتصالات إدراكات و لا شرائط فيها، و إن استمرت العادات بها. و الدليل عليه أنك تقول شممت الشي ء فلم أدرك ريحه، و ذقته فلم أجد طعمه، و لمسته فلم أدرك حرارته. و ذلك يحقق أنه ليس المراد بها في الإطلاق أنفس الإدراكات.
و عدّ أئمتنا رضي اللّه عنهم من الإدراكات وجدان الحي من نفسه الآلام و اللذات، و سائر الصفات المشروطة بالحياة. و لا سبيل إلى القول بأن وجدان هذه الصفات هو العلم بها؛ فإن الإنسان قد يضطر إلى العلم بتألم غيره، و يجد من نفسه الألم المختص به، و يفرق ببديهة عقله بين وجدانه ذلك من نفسه و بين علمه بألم غيره.
اتفق أهل الحق على أن كل موجود يجوز أن يرى. و ذهب المحققون منهم إلى أن كل إدراك، يجوز تعلقه بقبيل الموجودات في مجرى العادات، فسائغ تعلقه في قبيله بجميع الموجودات.
و المصحح لكون الشي ء بحيث أن يدرك هو الوجود، و يطرد ذلك في جميع الإدراكات، على ما سنبينه بالحجاج إن شاء اللّه عز و جل.
و قد تتصل أطراف الكلام بما لا يستغني المسترشد عن الإحاطة به، و ذلك أن قائلا لو قال:
هل يجوز أن يدرك المدرك إدراك نفسه، فالمرضي عندنا أنه يجوز أن يدرك المدرك إدراك نفسه، و إن لم يدركه فإنما لم يدركه لمانع ينافي إدراك
ص: 149
الإدراك، فيكون منعا منه و منعا من تقدير أن يدركه في نفسه.
و هل يجوز أن يتعلق إدراك الغير بإدراك غيره و موانعه؟ و هذا من الدقيق الذي لا يتأتى بسطه هاهنا.
كل ما يجوز أن يدرك فإذا لم يدركه المدرك. فإنما لم يدركه لقيام مانع به مضاد لإدراك ما يجوز أن يدركه. و تتعدد الموانع حسب تعدد تقدير الإدراكات، و هي متناهية الإعداد، إذ لا تنتفي النهاية عن أعداد المدركات.
و قد أنكرت المعتزلة الموانع التي أثبتناها مضادة للإدراكات. و زعموا أن الموانع منها القرب و البعد المفرطان، و عدم انبعاث الشعاع على شكل السداد، و عدم اتصاله بالمرئي. و الحجب الكثيفة غير الشفافة من الموانع على أصولهم. و حملوا العمى على انتقاض بنية الحاسة. و كل ما يدل على إثبات الأعراض دال على أن العمى، و كل مانع من الإدراك معنى؛ و لو جاز حمل العمى على انتقاض البنية.
و من أحاط بمآخذ الأدلة، هان عليه طرد الدليل الذي رمناه، و إن ابتغى مبتغ تجديد العهد بسبيل الدليل على ما نروم إثباته من الأعراض، فليسرد ما رسمناه في إثبات الأعراض حرفا حرفا.
فهذه المقدمات لم نجد من تقديمها بدّا.
ص: 150
ذكرنا من مذهب أهل الحق أن الباري سبحانه يجوز أن يرى، و نقلنا مخالفة المخالفين. ثم معظم المعتزلة مجمعون على أن الباري تعالى لا يرى نفسه، و هو في معتقد هؤلاء يستحيل أن يرى بالحواس و يستحيل أن يرى من غير حاسة. و ذهبت شرذمة من المعتزلة إلى أن الباري يرى نفسه، و إنما تمتنع على المحدثين رؤيته من حيث لا يرون إلا بالحاسة و اتصال الأشعة. و ذهب الكعبي و صحبه إلى أنه تعالى لا يرى، و لا يرى نفسه و لا غيره، و هذا مذهب النجار.
و الذي يعول عليه في إثبات جواز الرؤية بمدارك العقول، أن نقول: قد أدركنا شاهدا مختلفات، و هي الجواهر و الألوان، و حقيقة الوجود تشترك فيها المختلفات، و إنما يؤول اختلافها إلى أحوالها و صفات أنفسها، و الرؤية لا تتعلق بالأحوال. فإن كل ما يرى و يميز عن غيره في حكم الإدراك، فهو ذات على الحقيقة، و الأحوال ليست بذوات. فإذا تقرر بضرورة العقل أن الإدراك لا يتعلق إلا بالوجود، و حقيقة الوجود لا تختلف، فإذا رئى موجود لزم تجويز رؤية كل موجود؛ كما أنه إذا رئي جوهر، لزم تجويز رؤية كل جوهر؛ و هذا قاطع في إثبات ما نبغيه.
فإن قيل: لو كانت الرؤية لا تتعلق إلا بالموجود، لما أدرك المدرك اختلاف المدركات، و هذا السؤال وجّهه البهشمية؛ فإن من أصلهم: أن الإدراك لا يتعلق بالوجود، و إنما يتعلق بخاصّ وصف المدرك.
ص: 151
و الذي ذكروه في نهاية من التناقض؛ فإن ابن الجبائي امتنع من وصف الحال بكونها معلومة على حيالها، محاذرة من أن تتخيل الحال ذاتا، ثم زعم أنها المدركة دون الذات و وجودها. و كيف يستحيز اللبيب أن يحكم بأنه يدرك ما لا يعلم، مع القطع بأن تعلق العلم أعم من تعلق الإدراك؛ فإن العلم يتعلق بالوجود و العدم؛ و الإدراك لا يتعلق إلا بالذات الموصوفة بالوجود.
فإن قالوا: فما بال الحال علمت عند إدراك الوجود؟ قلنا: قولنا في العلم بالأحوال عند إدراك الوجود، كقولهم في العلم بالوجود عند إدراك الأحوال. ثم لا يبعد في مجاري العقول وجود اقتران معنيين، و هو بمثابة اقتران الآلام بالعلم بها، و المحل بالعرض، إلى غير ذلك.
و أما من نفى جواز الرؤية، فمما يعوّلون عليه أن الباري تعالى لو كان مرئيا لرأيناه في وقتنا؛ إذ الموانع من الرؤية منفية عنه، و هي القرب و البعد المفرطان، و الحجب الحائلة و نحوها، فلما لم نره كان ذلك دالّا على أنا لم نره لاستحالة رؤيته.
فنقول لهم: لم حصرتم الموانع فيما ذكرتموه؟ و لم أنكرتم مزيدا عليها؟ فلا يرجعون عند تحقيق الطلبة إلا إلى قولهم: سبرنا الموانع فلم نلف إلا ما أفصحنا به. فيقال لهم: عدم عثوركم على ضبط الموانع، لا ينتصب علما قاطعا، و أنتم عرضة للزلل، و لا يجب لكم العصمة، و لا الإحاطة بقصارى الأشياء و حقائقها، فلا يرجعون عند ذلك إلا إلى تردّد و تبلّد.
ص: 152
ثم نقول لهم: بم تنكرون على من يزعم أنا إنما لم نره لمانع قائم بالحاسة، مضادّ لإدراكه؟
فإن قالوا: مقاد هذا المذهب يفضي بمعتقده إلى أن يجوّز أن تكون بحضرته أطلال و أشخاص و أشباح، و أطوال شامخة و جبال راسخة؛ و هو لا يراها، إذ لم يخلق له الإدراك لها، و التزام ذلك جهل و انسلال عن موجب العقل.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه تعويل على تهويل لا تحصيل له، و هو على الفور ينعكس عليكم بالذي يغمض أجفانه، و يعتقد اقتدار الرب تعالى على أن يخلق في أوجز ما يقدر و أسرع ما ينتظر ما فرضتموه علينا؛ فما يؤمنه، و قد غمّض أو أطرق، أن يكون قد حدث بين يديه باختراع اللّه أطواد و أطلال؟ و مجوّز ذلك متجاهل.
و كذلك اتفق المنتمون إلى الإسلام على اقتدار الرب على أن يخلق بشرا سويا بديّا، من غير أن يردّده في أطوار الخلق من النطف و الأمشاج. و من رأى بشرا سويا، و استراب في كونه مولودا جريا على ما يجوّزه في قدرة اللّه تعالى كان والجا في نية الجهل.
و من الممكنات أن تجري الأودية دما عبيطا، و تنقلب الجبال ذهبا إبريزا، و لو جوّزه عاقل في دهره و قدره ممكنا في عصره، كان مهوّسا موسوسا، فكذلك سبيل القطع بأنه ليس بحضرتنا ما لا نشاهده.
فرجع ذلك، وقيتم البدع، إلى استقرار العوائد و استمرارها دون موجبات العقول. كيف و قد خصص الرسل برؤية الملائكة على القرب من صحبهم
ص: 153
و كانوا لا يرونهم، إذ الدهر دهر انخراق العوائد و وضوح المعجزات المجانبة للعادات.
و من شبههم: ما إذا تحقق رجع إلى محض الدعوى، مثل قولهم: الرائي يجب أن يكون مقابلا للمرئي، أو في حكم المقابل. فيقال لهم في هذا الضرب: أعلمتم ما ادّعيتموه ضرورة، أم علمتموه نظرا؟ فإن ادّعوا العلم الضروري و نسبوا خصومهم إلى جحده، سقطت محاجتهم و تبين بهتهم و تطرق إليهم من المجسمة مثل ما ادّعوه.
فإن قائلا منهم لو قال: باضطرار تعلم استحالة وجود موجود لا مجامع للعالم و لا مفارق له، لم تدفع هذه الدعوى إلا بمثل ما دفعنا به شبهة نفاة الرؤية. ثم الباري تعالى يرى خلقه من غير جهة، فجاز أن يرى في غير جهة.
و ينبغي للمبتدي في هذا الفن، أن لا يغفل عن معارضتهم بالعلم و كون الرب تعالى معلوما، في كل ما يتمسكون به في نفي جواز الرؤية.
قد ثبت بموجب العقل جواز رؤية الباري تعالى، و هذا الفصل يشتمل على أن الرؤية ستكون في الجنان، وعدا من اللّه تعالى صدقا و قولا حقا.
و الدليل عليه نصّ الكتاب، و هو قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ [سورة القيامة: 22- 23].
ص: 154
و النظر ينقسم معناه في اللغة، و تعتوره وصائل مختلفة على حسب اختلاف معانيه. فإن أريد به التقرب و الانتظار، استعمل من غير صلة؛ قال اللّه تعالى في الإنباء عن أحوال المنافقين و مخاطبتهم المؤمنين، و قد حيل بينهم و بينهم: انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ [سورة الحديد: 13]، معناه: انتظرونا.
و إن أريد بالنظر الفكر، وصل بفي، فتقول: نظرت في الأمر، إذا تدبرته. و إذا أريد به الترحم، وصل باللام، فتقول: نظرت لفلان. و إذا أريد به الإبصار، أي الرؤية وصل بإلى.
و النظر في الآية التي احتججنا بها موصول بإلى خبر عن الوجوه الناظرة المستبشرة، فاقتضاء النظر إثبات الرؤية. فإن عارضونا بقوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ [سورة الأنعام:
103]، قلنا: في الكلام على هذه الآية مسالك. منها، إن الرب تعالى لا يدرك جريا على ظاهر الآية، بل يرى. و إنما امتنع من سلك هذا المسلك من إطلاق الإدراك لإنبائه عن الإحاطة و تضمنه اللحوق، و إنما يلحق ذو الغايات، و الرب تعالى يتقدّس عن التحديد بالنهايات. و هؤلاء لا يمتنعون من إطلاق الإحاطة على معنى العلم، و يقولون: الرب تعالى يعلم على الحقيقة و لا يحاط به، و يرى و لا يدرك، ثم ليس في الآية نفي جواز الإدراك، و هو موضع الاختلاف الراجع إلى مدارك العقول.
ثم هذه الآية مطلقة غير مختصة بالأوقات، و هي عامة فيها، و الآية التي استدللنا بها تنص على إثبات الرؤية في أوقات معلومة، فيتجه في طرق التأويل حمل المطلق على المقيد، فيحمل نفي الإدراك على أيام الدنيا.
ص: 155
و إن عارضونا بقوله تعالى في جواب موسى عليه السلام: لَنْ تَرانِي [سورة الأعراف: 143]، فهذه الآية من أصدق الأدلة على ثبوت جواز الرؤية؛ فإن من اصطفاه اللّه لرسالته، و اختاره و اجتباه لنبوءته، و خصصه بتكريمه و شرّفه بتكليمه، يستحيل أن يجهل من حكم ربه ما يدركه حثالة المعتزلة.
و من نفى الرؤية نسب مثبت جوازها إما إلى ثبوت ما يقتضي تكفيرا، و إما إلى ثبوت ما يقتضي تضليلا، و الأنبياء عليهم السلام مبرّأون عن ذلك، كيف و قد ذهب مخالفونا إلى وجوب عصمتهم عن جميع الزلل!
فإن قال منهم قائل: إنما سأل موسى عليه السلام علما ضروريا، و عبر عنه بالرؤية، قيل له:
الرؤية المقرونة بالنظر الموصول «بإلى»، نص في الرؤية.
ثم الجواب يحمل على حسب الخطاب، فما بال المعتزلة حملوا: «لَنْ تَرانِي» على نفي الرؤية، و حملوا السؤال في صدر الآية على غير الرؤية؟
و إن قال منهم قائل: إنما سأل الرؤية لقومه قطعا لمعاذيرهم، إذ كانوا يسألونه أن يريهم اللّه جهرة، قيل له: هذا مخالفة للنص، فإنه عليه السلام أضاف الرؤية المسئولة إلى نفسه، حيث قال:
«أَرِنِي».
ثم كيف يظن بالكليم أن يسأل ربه ما يعلم استحالته في حكمه تعالى لأجل قومه! و لما سألوه و قد جاوزوا البحر أن يجعل لهم إلها، قال في الرّد عليهم: إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ [سورة الأعراف: 138].
ص: 156
و قد ذهبت شرذمة من المعتزلة، إلى أن موسى عليه السلام كان يعتقد جواز الرؤية غالطا، فأعلمه اللّه تعالى أنه لا يجوز ذلك، و تلك عظيمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، و هو من أعظم الازدراء بالأنبياء. و لو جاز ذلك، لجاز أن يعتقد نبي كون ربه جسما غالطا، ثم يعلمه اللّه و يلهمه الصواب.
فإن تبين أن سؤال موسى عليه السلام دال على جواز ما سئل عنه، ثم سؤاله كان عن رؤية في الحال، فلا يقدح في النبوّة ذهول النبي عليه الصلاة و السلام عن علم الغيب. فكان صلى اللّه عليه و سلّم يظن ما اعتقده جائزا ناجزا، فأعلمه الرب تعالى مكنون غيبه. ثم سؤاله كان عن رؤية في الحال، فتعيّن حمل النفي على موضع السؤال.
فإن قيل: قدمتم أن كل إدراك فإنه متعلق جوازا بكل موجود، و قوّد ذلك يلزمكم تجويز تعلق الإدراكات الخمسة بذات الباري و صفاته، و ملتزم ذلك ينتهي إلى الحكم بكون الرب تعالى مشموما ملموسا مذوقا. قلنا: قد ذكرنا أن اللمس و الذوق و الشمّ عبارات عن اتصالات، و ليست هي الإدراكات. فأما الإدراكات، مع القطع باستحالة الاتصال، فيجوز تعلقها بكل موجود، و كل دال على جواز رؤية كل موجود، يطرد في جميع الإدراكات.
فإن قيل: قد قدمتم في الصفات الواجبة، أن الرب تعالى سميع بصير، و أثبتم العلم بالسمع و البصر، فهل تثبتون للباري تعالى سائر الإدراكات؟ قلنا:
ص: 157
الصحيح عندنا إثباتها، و الدال على إثبات العلم بالسمع و البصر دال على جميع الإدراكات.
فهذا باب مما يجوز في أحكام الإله. و مما يتعلق بالجائز من أحكامه، ذكر خلقه و اختراعه المخترعات، و يتصل بذلك خلق الأعمال، و ما تمس الحاجة إليه من أحكام قدر العباد.
اتفق سلف الأمة، قبل ظهور البدع و الأهواء و اضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العالمين، و لا خالق سواه، و لا مخترع، إلا هو. فهذا هو مذهب أهل الحق؛ فالحوادث كلها حدثت بقدرة اللّه تعالى، و لا فرق بين ما تعلقت قدرة العباد به، و بين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه. و يخرج من مضمون هذا الأصل، أن كل مقدور لقادر، فاللّه تعالى قادر عليه و هو مخترعه و منشؤه.
و اتفقت المعتزلة، و من تابعهم من أهل الأهواء على أن العباد موجدون لأفعالهم، مخترعون لها بقدرهم. و اتفقوا أيضا على أن الرب تعالى عن قولهم، لا يتصف بالاقتدار على مقدور العباد، كما لا يتصف العباد بالاقتدار على مقدور الرب تعالى.
ثم المتقدمون منهم كانوا يمتنعون من تسمية العبد خالقا لقرب عهدهم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا اللّه تعالى، ثم تجرّأ المتأخرون منهم و سموا العبد خالقا على الحقيقة. و أبدع بعض المتأخرين ما فارق به ربقة الدين، فقالوا:
ص: 158
العبد خالق، و الرب تعالى عن قول المبطلين لا يسمى خالقا على الحقيقة. أعاذكم اللّه من البدع و التمادي في الضلالات.
و نحن الآن نرسم على المخالفين ثلاثة أضرب من الكلام؛ فأما الضرب الأول، فنتمسك فيه بالقواطع العقلية في خروج العبد عن كونه مخترعا؛ و نذكر في الضرب الثاني، إلزامات للمعتزلة مأخذها العقول أيضا، و الغرض منها إيضاح تناقض مذاهبهم؛ و نذكر في الضرب الثالث، الأدلة السمعية الدالة على صحة ما انتحاه أهل الحق.
أما الضرب الأوّل من الكلام، فينحصر المقصود منه في طريقتين. إحداهما، أن نقول لخصومنا: قد زعمتم أن مقدورات العباد ليست مقدورة للرب تعالى، مصيرا منكم إلى استحالة إثبات مقدور بين قادرين، فنقول لكم: الرب تعالى قبل أن أقدر عبده، و قبل أن اخترعه، هل كان موصوفا بالاقتدار على ما كان في معلومه أنه سيقدر عليه من يخترعه أم لا؟ فإن زعموا أنه تعالى لم يكن موصوفا بالاقتدار على ما سيقدر عليه العبد، فذلك ظاهر البطلان؛ فإن ما سيقدر عليه العبد عين مقدور اللّه تعالى، إذ هو من الجائزات الممكنات المتعلق بها قدرة العبد بعد في الصورة التي فرضنا السؤال عنها.
و إن كان يمتنع تعلق كون الباري تعالى قادرا بمقدور العبد، من حيث يستحيل عند الخصوم مقدور بين قادرين، فلا ينبغي أن يمتنع كون ما سيقدر عليه العبد مقدورا للّه تعالى قبل أن يقدر عليه العبد عنده، فإنه لم تتعلق به بعد
ص: 159
القدرة الحادثة. و إذا وجب كون ما سيقدر عليه العبد مقدورا للّه تعالى قبل أن يقدر عبده عليه، فإذا أقدره استحال أن يخرج ما كان مقدورا للّه تعالى عن كونه مقدورا له.
و لو تناقض في معتقد المخالفين بقاؤه مقدورا للرب تعالى مع تجدد تعلق قدرة العبد به، فاستبقاء كونه مقدورا للرب تعالى، و انتفاء كونه مقدورا للعبد، أولى من انقطاع تعلق كون الرب تعالى قادرا عليه لتجدد كونه مقدورا للعبد.
و إذا ثبت وجوب كون مقدور العبد مقدورا للّه تعالى، فكل ما هو مقدور له، فإنه محدثه و خالقه، إذ من المستحيل أن ينفرد العبد باختراع ما هو مقدور للرب تعالى.
و مما تمسك به أئمتنا أن قالوا: الأفعال المحكمة دالة على علم مخترعها، و تصدر من العبد أفعال في غفلته و ذهوله، و هي على الاتساق و الانتظام، و صفة الإتقان و الإحكام، و العبد غير عالم بما يصدر منه، فيجب أن يكون الصادر منه دالا على علم مخترعه. و إنما يتقرر ذلك على مذهب أهل الحق، الصائرين إلى أن مخترع الأفعال الرب تعالى، و هو عالم بحقائقها.
و من ذهب إلى أن العبد مخترع أفعاله، و هو غير عالم بها في الصورة التي وضعنا الدلالة فيها، فقد أخرج الإتقان و الإحكام عن كونه دالا على المتقن المخترع، و ذلك نقض للدلالة العقلية.
ثم لو ساغ وقوع محكم و فاعله غير عالم به، ساغ أيضا بطلان دلالة الفعل على القادر؛ و ذلك ينساق القول به إلى بطلان دلالة الفعل على الفاعل.
ص: 160
فإن عكسوا علينا ما ذكرناه في الكسب، و قالوا: يجب كون المكتسب عالما بما يكتسبه، ثم يجوز أن يصدر منه القليل من الأفعال و إن كان ذاهلا غافلا.
قلنا: لا يجب عندنا في حكم العقل كون المكتسب عالما بما يكتسبه، ثم يجوز أن يصدر منه القليل، إذ لو وجب ذلك في الكثير من الأفعال لوجب في القليل منها.
فإن قالوا: يجوز على ما أصّلتموه صدور الأفعال الكثيرة من العبد من غير علمه بها، قلنا: هذا مما نجوزه في موجب العقل، و إنما يمتنع وقوعه لإطراد العادات، و لو انخرقت لما امتنع في جائزات العقول ما طالبتمونا به.
فإن قالوا: قد ذكرتم عند الكلام في إثبات العلم بكونه تعالى عالما، أن ذلك إنما يعلم اضطرارا و لا يتوصل إليه نظرا و اعتبارا، فهذا ما ارتضيتموه. ثم هو مناقض لما استروحتم إليه الآن.
من حيث قلتم: الفعل المحكم دال على كون مخترعه عالما به؛ قلنا: هذا تلبيس منكم، و لا تناقض في الجمع بين ما قدمناه و بين ما استدللنا به الآن؛ فإنا، و إن قلنا: نعلم أن المحكم لا يصدر إلا من عالم على الضرورة، فحقيقة القول يؤول إلى أن المحكم دليل على كون فاعله عالما به، من غير احتياج إلى نظر في كونه دليلا. و كأن الأدلة تنقسم: فمنها ما لا يعلم كونه دليلا إلا بالنظر، و منها ما يعلم كونه دليلا على الضرورة؛ و الذي نحن فيه من القسم الأخير، و لا معنى لكون الشي ء دليلا على مدلول إلا أن يكون بحيث يجب من العلم به العلم بمدلوله، و هذا سبيل المحكم الدال على علم محكمه. و هذا الكلام في الضرب الأول.
ص: 161
فأما الضرب الثاني، و هو التعرض لإلزامهم، فإنه يشتمل على قواطع لا محيص عنها. فمن أقواها، أن القدرة الحادثة على أصولهم تتعلق بالوجود دون غيره من الصفات، ثم حقيقة الوجود لكل حادث لا تختلف، و اختلاف المختلفات يؤول إلى أحوالها الزائدة على وجودها، و ليست هي أثرا للقدرة. و من أصول القوم أن القدرة المتعلقة بالشي ء تتعلق بأمثاله و أضداده، و الموجودات مشتركة في حقيقة ما هو متعلق القدرة، فيجب تعلق القدرة الحادثة بجميع الحوادث كالطعوم و الألوان و الجواهر. كما يجب عندهم تعلق القدرة على حركة بجميع ما يماثلها، و لا محيص لهم عن ذلك.
فإن قالوا: ما ألزمتمونا في الاختراع ينقلب عليكم في تعلق القدرة كسبا، و إذا تعلقت القدرة بنوع من الأعراض لزمكم ما ألزمتمونا تجويز تعلقها بجميع الحوادث، و إن لم تلزموا ما عكس عليكم لم يستمر ما ألزمتموه؛ قلنا: القدرة الحادثة لا تتعلق عندنا بمحض الوجود، بل تتعلق بالذات و أحوالها، و الذوات مختلفة بأحوالها فلا يلزمنا من حكمنا بتعلق القدرة بشي ء الحكم بجواز تعلقها بما يخالفه. و إنما عظم موقع هذا الكلام على المعتزلة من حيث قالوا: لا تتعلق القدرة إلا بالوجود، ثم الوجود في حقيقته لا يختلف.
و مما يعظم موقعه عليهم، أنهم قالوا: القدرة الحادثة لا يتأتى بها إعادة ما اخترع بها أولا، و معلوم أن الإعادة بمثابة النشأة الأولى. و لذلك استدل الإسلاميون على اقتدار الرب على الإعادة باقتداره على ابتداء الفطرة، و قد نطق بذلك الكتاب، و احتج الرب على منكري الإعادة بالنشأة الأولى.
ص: 162
فإذا اعترفت المعتزلة بأن القدرة الحادثة لا تصلح لإعادة ما يجوز في العقل إعادته على الجملة، فكذلك ينبغي أن لا تصلح لابتداء الخلق. و إن ألزمونا تعلق القدرة الحادثة بالمعاد، التزمناه و لم نبعده؛ فإذا أعاد اللّه ما كان مقدورا للعبد، فيجوز أن يعيد قدرته عليه.
و مما نلزمهم به أن نقول: قد وافقتمونا على أن ما عدا الوجود من صفات الأفعال لا يقع بالقدرة الحادثة، مع أنها متجددة، كما أن الوجود متجدد، فما الفصل بين الوجود و بين الصفة الزائدة عليه؟
فإن قالوا: إذا ثبت وجود الحركة، وجب عند ثبوت وجودها ثبوت أحكام لها، و القدرة إنما تؤثر في الجائز دون الواجب، و الصفات التابعة للوجود واجبة؛ فلم تؤثر القدرة فيها؟ قلنا: لا معنى لوجوبها، إذ يجوز تقدير انتفائها أصلا إذا انتفى الوجود.
فإن قالوا: المعنى بوجوبها أنها إنما تجب عند ثبوت الوجود، قلنا: و كذلك يجب الوجود عند ثبوتها؛ فإنه كما يستحيل ثبوت الحدوث دون الصفات التابعة له، فكذلك يستحيل ثبوت الصفات التابعة له دون الحدوث، و لا محيص عن ذلك. فهذه إلزامات لا حيلة للخصوم في دفعها.
فأما الضرب الثالث من الكلام، فالغرض منه التعلق بالأدلة السمعية؛ و هي تنقسم إلى ما يتلقى من مواقع إجماع الأمة، و إلى ما يستفاد من نصوص الكتاب.
ص: 163
فأما ما يتلقى من إطلاق الأمة فأوجه: منها أن الأمة مجمعة على الابتهال إلى اللّه تعالى و إبداء الرغبة إليه في أن يرزقهم الإيمان و الإيقان و يجنبهم الكفر و الفسوق و العصيان، و لو كانت المعارف غير مقدورة للباري تعالى، لكانت هذه الدعوة الشائعة و الرغبة الذائعة، متعلقة بسؤال ما لا يقدر الباري عليه.
فإن قالوا: هذه الرغبة محمولة على سؤال الإقدار على الإيمان و الإعانة عليه بخلق القدرة، قلنا: هذا غير سديد على أصولكم؛ فإن كل مكلف قادر على الإيمان، و الرب تعالى لا يسلبه الاقتدار عليه، فلا وجه لحمل الدعاء على ابتغاء موجود، إذ الداعي يلتمس متوقعا مفقودا.
ثم السلف الصالحون كما سألوا اللّه تعالى الإيمان، كذلك سألوه أن يجنبهم الكفر، و القدرة على الإيمان قدرة على الكفر على أصول المعتزلة؛ فلئن كان الرب معينا على الإيمان بخلق القدرة عليه، فيجب أن يكون معينا على الكفر بخلق القدرة عليه. و يقوي موقع ذلك على الخصم، إذا فرضنا الكلام فيمن علم اللّه منه أنه إذا أقدره كفر؛ فإذا أقدره و الحالة هذه، فهو بالإعانة على الكفر أحق منه بالإعانة على الإيمان.
و من دعوات النبيين في ذلك قول إبراهيم و ابنه إسماعيل، صلوات اللّه عليهما: رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ [سورة البقرة: 128] الآية. و منها قول إبراهيم عليه السلام: وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ [سورة إبراهيم: 35].
ص: 164
و مما نتمسك به، تلقيا من إطلاق الأمة و إجماع الأئمة، أن المسلمين قبل أن تنبغ القدرية كانوا مجمعين على أن الرب تعالى مالك كل مخلوق، و رب كل محدث.
و من المستحيل أن يكون الباري تعالى مالكا ما لا يقدر عليه، و إله ما لا يعد من مقدوراته، و لا بد لكل مخلوق من رب و مالك و إذا كان العبد خالقا لأفعال نفسه لزم أن يكون ربها و إلهها، من حيث استبد بالاقتدار عليها، و هذه عظيمة في الدين، لا يبوء بها موفّق. و قد دل عليه فحوى التنزيل، فإنه عز من قائل قال: إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ، وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ [سورة المؤمنون: 91].
و مما نتلقاه من هذه المآخذ أن نقول: خلق المعرفة و الطاعات و القربات، أحسن من خلق الأجسام و أعراضها التي ليست من قبيل الطاعات، فلو اتصف العبد بخلق المعارف لكان أحسن خلقا من ربه، و لكان أولى بإصلاح نفسه و إرشادها و إنقاذها من الغيّ و المعاطب من ربه. و من زعم أن العبد أصلح لنفسه من ربه، فقد راغم إجماع المسلمين و فارق الدين.
و إن قالوا: لولا القدرة على الإيمان لما تمكن العبد من خلق الإيمان، فالقدرة إذا أصلح و أحسن؛ قلنا مضمون ذلك يلزم صاحب هذا المقال أن يجعل القدرة على الكفر شرا من الكفر، حيث إنه لا يتمكن منه إلا بها، و القدرة صالحة للضدين، و ليست بأحدهما أولى منها بالآخر؛ فلئن كان الرب تعالى مصلحا عبده بالاقتدار على الإيمان، فليكن مفسدا له بالتمكن من الكفر. و هذا القدر كاف في مقصودنا من مآخذ إطلاق الأمة.
ص: 165
فأما نصوص الكتاب، فمنها قوله تعالى: ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ [سورة الأنعام: 102] الآية. و الآية تقتضي تفرد الباري تعالى بخلق كل مخلوق، و الاستدلال بها يعتضد بأنّا نعلم أن فحواها يتضمن التمدح بالاختراع و الإبداع، و التفرد بخلق كل شي ء؛ فلو كان غيره خالقا مبدعا لانتفى التمدح بالخلق المحمول على الخصوص، و لساغ للعبد أن يتمدح بأنه خالق كل شي ء، و مراده أنه خالق لبعض المخلوقات.
فإن قالوا: هذا الذي تمسكتم به عموم، و للعلماء في الصيغ العامة مذهبان: أحدهما جحد اقتضاء الألفاظ للعموم، و الثاني القول بالعموم مع المصير إلى تعرضه للتأويل، و كل ظاهر متعرض لجهات الاحتمالات، فلا يسوغ التمسك به في القطعيات. قلنا: لم نتمسك بمحض الصيغة حتى أوضحنا اقترانها بإرادة التمدح، و بينا أن ذلك التمدح مفهوم من مقتضى الآية على قطع، و لا يستمر حمل الآية على الخصوص مع ما استيقناه من التمدح، و المفهوم و إن لم يستفد من مجرد الصيغ فهو متلقى من القرائن.
و على هذا الوجه يستدل بقوله تعالى: أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ [سورة الرعد: 16] الآية. و هذه الآية نص في محل النزاع. فإن قالوا:
هي متروكة الظاهر، و كذلك التي استدللتم بها قبل، فإن الظاهر في الآيتين يقتضي كون الرب تعالى خالق كل شي ء، و اسم الشي ء يطلق على القديم و الحادث. قلنا: المخاطب المتكلم في هذه المواضع لا يدخل تحت قضية الخطاب، و نظير ذلك قول القائل: «لا يلقاني خصم منطيق و لا جدل ذو تحقيق إلا أفحمته»، فلا يتوهم عاقل دخول هذا المخبر عن نفسه
ص: 166
تحت موجب كلامه، حتى يقدر كونه مفحما نفسه. و لا تندرئ قواطع النصوص بالروغان و الحيل.
و نستدل بكل آية في كتاب اللّه دالة على تمدح الباري تعالى بكونه قادرا على كل شي ء، و لا معنى لذلك عند المعتزلة، فإن المعنى بقوله تعالى: وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ [سورة البقرة: 284]، أنه قادر على أفعال نفسه و ليس بمقتدر على أفعال غيره. و إذا كان الأمر كذلك، فالعبد أيضا قادر على كل شي ء على هذا التأويل، و يبطل تمدح الباري تعالى عند التحصيل.
و مما يستدل به أيضا قوله تعالى: وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ [سورة الصافات: 96]. و سنعقد فصلا في معنى الهدى و الضلال، و الختم و الطبع و شرح الصدور و نعتصم فيه بالقواطع من نصوص الكتاب و فحوى الخطاب.
و قد حان أن نذكر عصم المعتزلة و شبههم و هي تنقسم عندهم إلى مدارك العقول و مآخذ السمع.
فمما تمسكوا به في مدارك العقول، أن قالوا: العاقل يميز بين مقدوره، و بين ما ليس بمقدوره؛ و يدرك تفرقة بين حركاته الإرادية، و ألوانه التي لا اقتدار له عليها. و وجه الفصل بين القبيلين أنه يصادف مقدوره واقعا به على حسب قصوده و دواعيه، و لا يقع منه ما لا يقع على حسب انكفافه و انصرافه. فإذا صادف الشي ء واقعا على حسب المقصود و الداعية، لم يسترب في وقوعه به، ثم لا يقع به إلا الحدوث، فليكن العبد محدثا لفعله. و لو كان فعله غير واقع به، لكان بمثابة لونه و سائر صفاته الخارجة عن مقدوراته.
ص: 167
قلنا: هذا الذي عولتم عليه، دعاوى غير مقرونة بأدلة. فأما قولكم: إن المقدور يقع على حسب الداعية و القصد، فباطل من أوجه، منها: أن ذلك لا يعم الأحوال و لا يشمل الأفعال، بل الأمر على الانقسام؛ فرب فعل يقع على حسب القصد، و ربما لا يقع على حسبه، فإن أفعال العاقل الذاهل غير واقعة على حسب قصده و دواعيه، و كذلك كل ما يصدر من النائم و المغمى عليه من الأفعال.
فإذا لم يطرد ما قالوه في جميع الأفعال، فوقوع بعضها على حسب الداعية لا يدل على كونه واقعا بالعبد من فعله. فإنه قد يقع الشبع عند الأكل، و الري عند الشرب، و اكتساب الثوب ألوانا مقصودة عند الصبغ، و فهم المخاطب عند الإفهام، و خجله و وجله عند التخجيل و التهويل؛ فهذه الأفعال، مع وقوعها على حسب المقصود، ليست أفعالا لذي الدواعي و القصود.
ثم نقول: من اعتقد أن لا خالق إلا اللّه فلا تدعوه داعية إلى الخلق، و لا يصح مع هذا الاعتقاد منه القصد إلى الإحداث. و أفعال معظم الخليقة غير واقعة على حسب القصد، فإن المقصود الواقع بالعبد عند الخصوم الحدوث. فإذا وضح أنه غير مقصود من الذين ذكرناهم، بطل استرواحهم إلى الدواعي، و فسد ما عولوا عليه من الدعاوى.
ثم نقول: لا يبعد عندكم أن يخلق الباري تعالى في العبد أكوانا ضرورية، و يخلق فيه الدواعي ضرورية إليها على الاطراد، و لو كان الأمر كذلك لكانت الأكوان واقعة على حسب الدواعي. ثم لا نقضي، و الحال هذه، بكون الأكوان
ص: 168
الضرورية الواقعة على حسب الدواعي أفعالا لذي الدواعي، فبطل ما عولوا عليه من كل وجه.
و ما ذكروه من إدراك التفرقة بين المقدور و غيره صحيح، و لكن التفرقة آيلة إلى إدراك تعلق القدرة بأحدهما دون الثاني، و هو كالفرق بين المعلوم و المظنون، مع العلم بأن العلم و الظن لا يؤثران في متعلقهما.
و مما تمسكوا به، و هو من أعظم تخيلاتهم، أن قالوا: العبد مطالب من ربه تعالى بالطاعة، و يستحيل في العقول أن يطالب العبد بما لا يقع منه. قالوا: المقدور عندكم بمثابة القدرة في أن كل واحد منهما واقع بقدرة اللّه تعالى، و ليس للعبد من إيقاع المقدور شي ء، فما المطلوب؟ و ما معنى الطلب؟ و ما الفرق بين مطالبة العبد بألوانه و أجسامه، و بين مطالبته بأفعاله؟
و ربما قرروا هذه الشبهة، و قالوا: لسنا نلزمكم الآن أمرا يتعلق بتقبيح العمل و تحسينه، و لكن أهل الملل متفقون على أن ما يؤدي إلى حمل كلام الرب تعالى على التناقض و الخروج عن الإفادة فهو باطل. و من لغو الكلام أن يقول القائل لمن يخاطبه: افعل ما أنا فاعله، و ابدع ما أنا مبدعه.
و سبيلنا أن نفاتح المعتزلة بعكس هذه الشبهة عليهم من أوجه، منها أن نقول: من أصلكم أن المعدوم شي ء و ذات على خصائص الصفات، فما معنى
ص: 169
المطالبة بإثبات ما هو ثابت؟ إذ لا معنى لكون المعلوم موجودا، إلا أنه ثابت ذات لها خصائص صفات. و هذا الذي ألزمناهم يبطل عليهم معنى الخلق في حكم اللّه سبحانه و تعالى.
فأما من أنكر الأحوال من المعتزلة، فلا مطمع له في الانفصال عما ذكرناه. و من قال بالأحوال من المنتمين إلى الاعتزال، فربما يقولون: المطلوب هو الوجود، و هو حال متجددة للذات، و ذلك محال. فإن الحال لو كانت تنفرد بالإثبات عن الانتفاء، لكانت ذاتا؛ إذ كل ما يتخيل منتفيا، ثم يعتقد تجدده على ذات واقعا بالقدرة على حياله و انفراده فهو ذات. و لو ساغ صرف أثر القدرة إلى الحال، لجاز أن يقال، إذا سكن الجوهر عن تحرك، فكونه ساكنا حال ثابتة بالقدرة، من غير احتياج إلى تقدير سكون هو عرض زائد عن الذات، و ذلك يقضي بإنكار الأعراض، و لا محيص لهم عن ذلك.
و مما انعكس به شبههم أن نقول: العبد عندكم مطالب بالنظر ابتداء، و لما يعتقد بعد أمرا مطالبا، فكيف التوصل إلى العلم بالطلب قبل استيقان الطالب الأمر؟
و ما عولوا عليه من إلزامنا تناقض الطلب قولا، ينعكس عليهم بما لا يجدون عنه محيصا، و ذلك أنّا نقول: من أصلكم أن الرب تعلى مصلح عباده بما كلفهم من طاعته، فإذا فرضنا الكلام عليكم فيمن علم اللّه تعالى أنه لو اخترمه و لم يكمل عقله لنجا من العذاب. و لو أكمل عقله و أقدره لكفر و طغى، فمن هذه حاله، فصلاحه على الضرورة في أن يخترم. و من أبدى في ذلك مراء سقطت
ص: 170
مكالمته و دحضت حجته. و كل كلام في اقتضاء تكليف فهو مقيد بقصد الإصلاح.
و لا مزيد في التناقض على أن يقول القائل: آمرك و قصدي بأمرك إصلاحك، مع علمي بأنك لا تصلح، و لو لم آمرك لنجوت من موبقات العواقب و مرديات العواطب. فهذا، وقيتم البدع، غاية في التناقض لا يخفى مدركها على عاقل.
و مما يعارضون به، أن أوامر الشرع و زواجره قد تتعلق بالأحوال المعللة بعللها، و ذلك مثل تقدير الشرع بأمر مكلف بكونه قائما عالما، و لا سبيل إلى جحد ذلك من موارد الشرع و موجبات السمع. ثم كون العالم عالما، و إن حسن تقدير الطلب فيه، فليس هو واقعا بالمطالب به على أصول المخالفين، فإنه لا يقع بالقدرة إلا حدوث ذات. و الأحوال توجبها العلل، و تثبت واجبة تابعة للحدوث؛ فإذا لم يبعد تقدير الطلب بما لا يقع بالمطالب، لم يبعد ما ألزمونا.
ثم نقول: ما أسندتم إليه تخييلكم محض تهويل. فإنا نقول قد سبقت معرفتكم بأن خصومكم لا يعتقدون كون العبد المأمور و المنهي موقعا لفعله، ثم علمتم اتفاق أهل الملل على توجه الأوامر على المكلفين، ثم ادعيتم بعد هذين الأصلين استحالة الطلب فيما لا يوقعه المطالب.
و سبيل إيجاز الكلام أن نقول: ما ادعيتم استحالته، لا تخلون فيه من أمرين: إما أن تسندوا دعواكم إلى الضرورة، و إما أن تسندوها إلى دليل على زعمكم. و إن ادعيتم العلم الضروري، كنتم مباهتين في ادعاء الضرورة بإزاء مخالفة أكثر
ص: 171
الأمة، ثم لا تسلمون من معارضة دعواكم بمثلها. و إن أسندتم تصحيح دعواكم إلى نظر، فأبدوه نتكلم عليه، و لا تقتصروا على الدعوى العرية.
و قد سلك بعض أئمتنا طريقا في الكسب تدرأ هذه الشبهة، على ما سنعقد في حقيقة الكسب فصلا، و ذلك أنه قال: القدرة الحادثة تتضمن إثبات حال للمقدور بها، و تلك الحال متعلق الطلب.
و الخلق على أصول المعتزلة لا يتضمن إثبات ذات، إذ الذوات عندهم ثابتة عدما و وجودا على صفات أنفسها. و إنما يتضمن الاختراع وجود الذات، و هو حال عند محققيهم.
شبهة أخرى لهم، و هي أنهم قالوا: إذا حكمتم بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في متعلقها، فسبيلها سبيل العلم المتعلق بالمعلوم، و يلزم على مقتضى ذلك تجويز تعلق القدرة الحادثة بالألوان و الأجسام و القديم و جميع الحوادث قياسا لها على المعلوم. و هذا الذي موهوا به دعوى، و هم بإثباتها مطالبون، و كل مشبه شيئا بشي ء مطالب بالدليل على إثبات تشابههما في الوجه الذي يبغيه المشبه.
فإن قالوا: الجامع بين القدر و العلوم استواؤهما في انتقاء تأثيرهما في متعلقاتهما، قلنا: لم قلتم إن العلوم عم تعلقها لأنه لا أثر لها؟ و لا يتخلصون من المطالبة أو يوردوا دليلا، و لا يكادون يهتدون إليه سبيلا. ثم الرؤية لا تؤثر في المرئي، و لا تتعلق بجميع الموجودات على مذهب الخصم. و العلم بسواد معين لا يتعلق بغيره، و إن لم يكن له أثر في المعلوم به، فبطل ما عولوا عليه.
ص: 172
ثم ما ذكروه ينعكس عليهم بما لا محيص لهم عنه. و ذلك أن حقيقة الحدوث لا تختلف، و هي أثر القدرة عند الخصم، و الصفات التي تختلف بها الحوادث ليست من آثار القدرة. فهلا قضوا بتعلق القدرة الحادثة بكل حادث، من حيث لا يختلف متعلق القدرة الحادثة و أثرها في جميعها!
شبهة أخرى لهم، و ذلك أنهم قالوا: العبد مثاب على فعله معاقب ملوم محمود، و كل ذلك دال على أن فعله واقع منه، إذ لا يحسن توبيخه و الثناء عليه بما لا يقع منه كألوانه و أجسامه. و هذا الذي ذكروه لا محصول له؛ فإن الثواب و العقاب و توابعهما من الذم و المدح لا يوجبها فعل المكلف عندنا. و لو ابتدأ الرب تعالى عبده بنعيم مقيم أو بعذاب أليم، لكان ذلك ممكنا غير مستحيل. و إنما أفعال العباد في أحكام الشرائع أعلام و آيات لأحكام اللّه تعالى، و لا بعد في نصب علم ليس هو واقعا بمن نصب العلم له. و سنقرر ذلك في باب الثواب و العقاب إن شاء اللّه عز و جل.
فإن قيل: إنما يتكلم على المذهب ردا و قبولا إذا كان معقولا، و ما اعتقدتموه من كون العبد مكتسبا غير معقول؛ فإن القدرة إذا لم تؤثر في مقدورها، و لم يقع المقدور بها، فلا معنى لتعلق القدرة. قلنا: قد اختلف أئمتنا في وجه تعلق القدرة الحادثة بمقدورها.
فصار صائرون إلى أن القدرة الحادثة تؤثر في إثبات حال للمقدور يتميز بها المكتسب عن الضروري. فإذا فرضنا حركة ضرورية إلى جهة، و قدرنا أخرى
ص: 173
كسبية إلى تلك الجهة، فالكسبية على حالة زائدة هي من أثر تعلق القدرة الحادثة بها، و الكسبية تتميز بها عن الضرورية. و أما الحدوث، و إثبات الذوات، فالرب تعالى مستأثر بها.
و هذه الطريقة غير مرضية، و لا جريان لها على قواعد أهل الحق، و في المصير إليها افتتاح وجوه من الفساد يجب تنكّبها.
منها، أن العبد يستحيل أن ينفرد بمقدور دون الرب تعالى؛ فإن فرضنا للقدرة الحادثة أثرا، و حكمنا بثبوته للعبد، فقد خرمنا اعتقاد وجوب كون الرب قادرا على كل شي ء مقدور. و يستحيل المصير إلى أن الحالة المفروضة تقع بالقدرة القديمة و الحادثة، فإن ذلك مستحيل، و لو ساغ فرضه لساغ تقدير خلق بين خالقين.
على أن صاحب هذه الطريقة يحيل معتقده على ادعاء حالة مجهولة لا يمكنه الإفصاح بها، مع قطعنا بأن الحركة الكسبية مماثلة للضرورية. و تقدير أحوال مجهولة حيد عن السداد، و تطريق لدواعي الفساد إلى أصول الاعتقاد.
فالوجه، القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلا و ليس من شرط تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها؛ إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه، و كذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها. فإن استبعد الخصوم ذلك، و رجعوا إلى كون العبد مطالبا، فقد قدمنا ما فيه إقناع في الانفصال.
ص: 174
اعلم، وفقك اللّه تعالى لمرضاته، أن كتاب اللّه العزيز اشتمل على آي دالة على تفرد الرب تعالى بهداية الخلق و إضلالهم، و الطبع على قلوب الكفرة منهم، و هي نصوص لإبطال مذاهب مخالفي أهل الحق. و نحن نذكر غرضنا من آيات الهدى و الضلال، ثم نتبعها بالآي المحتوية على ذكر الختم و الطبع.
فمما يعظم موقعه عليهم، قوله تعالى: وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ [سورة يونس: 25]؛ و قوله تعالى: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ [سورة القصص: 56]؛ و قوله تعالى: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً [سورة الأنعام: 125]؛ و قال عز و جل: مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَ مَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ [سورة الأعراف: 178].
و اعلم أن الهدى في هذه الآية لا يتجه حمله إلا على خلق الإيمان، و كذلك لا يتجه حمل الإضلال على غير خلق الضلال. و لسنا ننكر ورود الهداية في كتاب اللّه عز و جل على غير المعنى الذي رمناه، فقد يرد و المراد به الدعوة؛ قال اللّه تعالى: وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ [سورة الشورى: 52]، معناه و إنك لتدعو.
و قد ترد الهداية و يراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان و الطرق المفضية إليها يوم القيامة، قال اللّه تعالى: فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصْلِحُ بالَهُمْ
ص: 175
[سورة محمد: 4- 5]؛ فذكر اللّه تعالى المجاهدين في سبيله و عنى بهم المهاجرين و الأنصار، ثم قال: «سَيَهْدِيهِمْ»، فينبغي حمل الآية على ما ذكرناه. و قال اللّه تعالى في الكفار: فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ [سورة الصافات: 23]، معناه اسلكوا بهم إليها، و المعنى بقوله تعالى: وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ [سورة فصلت: 17]، الدعوة؛ و معنى الآية، أنا دعوناهم فاستحبوا العمى على ما دعوا إليه من الهدى.
و إنما أشرنا إلى انقسام معنى الهدى و الضلال، لتحيطوا علما بأننا لا ننكر ورود الهدى و الضلال على غير معنى الخلق، و لكنا خصصنا استدلالنا بالآي التي صدرنا الفصل بها. و لا سبيل إلى حملها على الدعوة، فإنه تعالى فصل بين الدعوى و الهداية، فقال: وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ [سورة يونس؛ 25]، فخصص الهداية و عمم الدعوة، و هذا مقتضى ما استدللنا به من الآيات. و لا وجه لحملها على الإرشاد إلى طريق الجنان، فإن اللّه تعالى علق الهداية على مشيئته و إرادته و اختياره. و كل مستوجب الجنان، فحتم على اللّه عند المعتزلة أن يدخله الجنة. و قوله تعالى: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ [سورة الأنعام: 125]، فصرح بأحكام الدنيا.
و شرح الصدر و حرجه، و ذكر الإسلام من أصدق الآيات على ما قلناه.
و إن استشهد المعتزلة في روم حمل الهداية على الدعوة أو غيرها مما يطابق معتقدهم بالآيات التي تلوناها، فالوجه أن نقول: لا بعد في حمل ما استشهدتم به على ما ذكرتموه، و إنما استدللنا بالآيات المفصلة المخصصة للهدى بقوم و الضلالة بآخرين، مع التنصيص على ذكر الإسلام و شرح الصدور و حرجه له. و لا مجال لتأويلاتهم المزخرفة في النصوص التي استدللنا بها.
ص: 176
و أما آيات الطبع و الختم، فمنها قوله تعالى: خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ [سورة البقرة: 7]؛ و قوله تعالى: بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ [سورة النساء: 155]؛ و قوله تعالى: وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً [سورة الأنعام: 25]؛ و قوله تعالى: وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً [سورة المائدة: 13].
و قد حارت المعتزلة في هذه الآيات، و اضطربت لها آراؤهم، فذهبت طائفة من البصريين إلى حملها على تسمية الرب تعالى الكفرة بنبذ الكفر و الضلال؛ قالوا: فهذا معنى الطبع.
و لا خفاء بسقوط هذا الكلام، فإن الرب تعالى تمدح بهذه الآيات و أنبأ بها عن اقتهاره و اقتداره على ضمائر العباد و إسرارهم. و بين أن القلوب بحكمه يقلبها كيف يشاء، و صرح بذلك في قوله تعالى: وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ [سورة الأنعام: 110] الآية. فكيف يستجاز حمل هذه الآيات على تسمية و تلقيب؟ و كيف يسوغ ذلك للبيب؟ و الواحد منا لا يعجز عن التسميات و التلقيبات، فما وجه استيثار الرب بسلطانه؟
و حمل الجبائي و ابنه هذه الآيات على محمل بشيع مؤذن بقلة اكتراثهما بالدين، و ذلك أنهما قالا: من كفر و سم اللّه قلبه سمة يعلمها الملائكة، فإذا ختموا على القلوب تميزت لهم قلوب الكفار من أفئدة الأبرار. فهذا معنى الختم عندهما، و ما ذكراه مخالفة لنص الكتاب و فحوى الخطاب؛ فإن الآيات نصوص في أن اللّه تعالى يصرف بالطبع و الختم عن سنن الرشاد من أراد صرفه من العباد؛ قال اللّه تعالى: وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً
ص: 177
[فصلت: 5]، فاقتضت الآيات كون الأكنة مانعة من إدراك الإيمان. و السمة التي اخترعوا القول بها، لا تمنع من الإدراك.
و إلى متى نتعدى غرضنا في الاختصار، و قد وضح الحق و حصحص، و استبان عناد المخالفين في تأويلاتهم! و اللّه الموفق للصواب.
العبد قادر على كسبه، و قدرته ثابتة عليه. و ذهبت الجبرية (1)إلى نفي القدرة، و زعموا أن ما يسمى كسبا للعبد أو فعلا له، فهو على سبيل التوسع و التجوز في الإطلاق، و الحركات الاختيارية و الإرادية بمثابة الرعدة و الرعشة.
و الدليل على إثبات القدرة، أن العبد إذا ارتعدت يده، ثم إنه حركها قصدا، فإنه يفرق بين حالته في الحركة الضرورية و بين الحالة التي اختارها و اكتسبها، و التفرقة بين حالتي الاضطرار و الاختيار معلومة على الضرورة. و يستحيل رجوعها إلى اختلاف الحركتين، فإن الضرورة مماثلة للاختيارية قطعا؛ فكل واحدة من الحركتين ذهاب في الجهة الواحدة و انتقال إليها، و لا وجه لادّعاء افتراقهما بصفة مجهولة تدّعى، فإن ذلك يحسم طريق العلم بتماثل كل مثلين؛ فإذا لم ترجع التفرقة إلى الحركتين، تعين صرفها إلى صفة المتحرك.
ص: 178
ثم نسلك بعد ذلك سبيل السبر و التقسيم في إثبات القدرة، على ما سبق التنبيه عليه عند محاولة الدليل على إثبات الأعراض، فنقول: يستحيل رجوع التفرقة إلى نفس الفاعل من غير مزيد، فإن الأمر لو كان كذلك لاستمرت صفة النفس ما دامت النفس.
فإذا رجعت التفرقة إلى زائد على النفس و لم يخل ذلك الزائد: إما أن يكون حالا، أو عرضا.
و باطل أن يكون حالا، فإن الحال المجردة لا تطرأ على الجواهر، بل تتبع موجودا طارئا كما قدمناه؛ و إن كان ذلك الزائد عرضا، يتعين كونه قدرة، فإنه ما من صفة من صفات المكتسب غير القدرة إلا و يتصور ثبوتها مع انتفاء الاقتدار، و تنتفي معظم الصفات المغايرة للقدرة، مع ثبوت القدرة. و لسنا نستوعب الأقسام في مقدم الكلام، بل نجتزئ بالتنبيه عليه.
فإن قيل: بم تنكرون على من يصرف التفرقة إلى ثبوت الإرادة و الكراهية؟ قلنا: العاقل يفرق بين تحريكه يده و بين ارتعاده و إن لم يكن له إرادة في حالتي غفلته و ذهوله.
فإن قيل: بم تردون على من يصرف التفرقة إلى صحة في الجارحة و بنية مخصوصة، و إلى انتفائها؟ قلنا: هذا باطل من أوجه، أقربها إلى غرضنا: أن الأيّد الصحيح البنية يفرق بين أن يحرك يد نفسه قصدا، و بين أن يحرك الغير يده، و إن كانت بنية يده في الحالتين على صفة واحدة. فإذا بطلت هذه الأقسام، تعين التنصيص على القدرة، و هذا سبيلنا في تعيين كل غرض ينازع فيه.
ص: 179
القدرة الحادثة عرض من الأعراض عندنا، و هي غير باقية، و هذا حكم جميع الأعراض عندنا، و أطبقت المعتزلة على بقاء القدرة و الدليل على استحالة بقاء جميع الأعراض أنها لو بقيت لاستحال عدمها.
و نفرض هذا الدليل في القدرة ثم نستبين اطراده فيما عداها، فنقول: لو بقيت القدرة ثم قدّر عدمها لم يخل القول في ذلك: إما أن يقدر انتفاؤها بطريان ضد، و هو مذهب المخالفين؛ و إما أن يقدر انتفاؤها بانتفاء شرط لها. و باطل تقدير عدمها بطريان ضد، فإنه ليس الضد الطارئ بنفي القدرة أولى من درء القدرة الضد و منعها إياه من الطريان. ثم إذا تعاقب ضدان، فالثاني يوجد في حال عدم الأول، فإذا تحقق عدمه فلا حاجة إلى الضد، و قد تصرم ما قبله.
و باطل أن يقال تنتفي القدرة بانتفاء شرط لها فإن شرطها لا يخلو: إما أن يكون عرضا، و إما أن يكون جوهرا، فإن كان عرضا: فالكلام في بقائه و انتفائه كالكلام في القدرة، و إن كان جوهرا فلا يتصور مع القول ببقاء الأعراض انتفاء الجواهر، فإن سبيل انتفائها قطع الأعراض عنها فإذا قضى ببقاء الأعراض لم يتصور عدمها؛ فإذا امتنع تقدير عدمها امتنع عدم الجواهر، و قد ذكرنا طرفا من ذلك في الصفات.
ص: 180
و يبطل المصير إلى أن القدرة تعدم بإعدام اللّه إياها فإن الإعدام هو العدم، و العدم نفي محض؛ و يستحيل أن يكون المقدور نفيا؛ إذ لا فرق بين أن يقال: لا مقدور للقدرة، و بين أن يقال مقدورها منتف.
إذا ثبت استحالة بقاء القدرة الحادثة فإنها تفارق حدوث المقدور بها، و لا تتقدم عليه، و لو قدرنا سبق الاعتقاد إلى بقاء القدرة الحادثة لما استحال تقدمها على وقوع مقدورها، و لذلك يجب القطع بتقدم القدرة الأزلية على وقوع المقدورات بها. فلما ثبت أن القدرة الحادثة لا تبقى، ترتب على ذلك استحالة تقدمها على المقدور، فإنها لو تقدمت عليه لوقع المقدور مع انتفاء القدرة، و ذلك مستحيل لما سنذكره إن شاء اللّه عز و جل.
الحادث في حال حدوثه مقدور بالقدرة القديمة، و إن كان متعلقا للقدرة الحادثة فهو مقدور بها. و إذا بقي مقدور من مقدورات الباري تعالى، و هو الجوهر، لا يبقى غيره من الحوادث، فلا يتصف في حال بقائه و استمرار وجوده بكونه مقدورا إجماعا.
و ذهبت المعتزلة إلى أن الحادث في حال حدوثه، يستحيل أن يكون مقدورا للقديم و الحادث، و هو بمثابة الباقي المستمر، و إنما تتعلق القدرة بالمقدور في
ص: 181
حالة عدمه. و قالوا على طرد ذلك: يجب تقديم الاستطاعة على المقدور، و يجوز مقارنة ذات القدرة حدوث المقدور من غير أن تكون متعلقة به حال وقوعه.
و الدليل على أن الحادث مقدور، و أن الاستطاعة تقارن الفعل، أن نقول: القدرة من الصفات المتعلقة، و يستحيل تقديرها دون متعلق لها، فإن فرضنا قدرة متقدمة، و فرضنا مقدورا بعدها في حالتين متعاقبتين فلا يتقرر على أصول المعتزلة تعلق القدرة بالمقدور. فإنا إذا نظرنا إلى الحالة الأولى، فلا يتصور فيها وقوع المقدور، و إن نظرنا إلى الحالة الثانية فلا تعلق للقدرة فيها. فإذا لم يتحقق في الحالة الأولى إمكان، و لم يتقرر في الحالة الثانية اقتدار، فلا يبقى لتعلق القدرة معنى.
و نعتضد بعد ذلك بوجهين، أحدهما أن المقدور لا يخلو: إما أن يكون عدما، و إما أن يكون وجودا؛ و يستحيل كونه عدما فإنه نفي محض، و الموجود عند المخالفين غير مقدور. و الوجه الثاني أنهم زعموا أن الحادث بمثابة الباقي في استحالة كونه مقدورا. ثم الإمكان في الحالة الأولى من وجود القدرة، و الحالة المتوقعة بعدها ليست حالة تعلق القدرة؛ فإن ساغ ذلك فليكن الباقي مقدورا في الحالة الأولى من القدرة، كما أن الحادث مقدور قبل وقوعه في الحالة الأولى من القدرة، و لا محيص لهم عن ذلك.
فإن قالوا: الحادث واقع كائن، و الحاجة تمس إلى القدرة للإيقاع بها؛ و إذا تحقق وقوع الحادث بها انتفت الحاجة إلى القدرة، و ينزل الحادث منزلة الباقي المستمر. قلنا: هذا الذي ذكرتموه يبطل بالحكم المعلل بالعلة الموجبة له، فإن الحكم في حال ثبوته تقارنه العلة، و ليس لقائل أن يقول: إذا ثبت الحكم لم يحتج
ص: 182
مع ثبوته إلى تقدير علة مقارنة له. و كذلك السبب المولّد، قد يقارن وقوع المسبب و يجب ذلك فيه، كما نذكره بعد الاستطاعة إن شاء اللّه عز و جل.
ثم حق العاقل أن يفرض في تصوره ثلاثة أحوال: حالة عدم، و حالة حدوث بعدها، و حالة بقاء بعد الحدوث. فأما حالة العدم فجارية على استمرار الانتفاء؛ و أما الحالة الثانية فلو كانت لا تتعلق بالقدرة فيها لاستمر العدم، فلما تعلقت القدرة كان الوجود بدلا من العدم المجوز استمراره؛ و أما الحالة الثالثة، فقد استمر الوجود فيها، فلا حاجة إلى تقدير تعلق القدرة.
ثم، قد التزمت المعتزلة أمرا لا خفاء ببطلانه، فقالوا: إذا تقدمت القدرة على المقدور بحالة واحدة، فيجوز أن يقع في الحالة الثانية عجز مضاد للقدرة. ثم العجز يظهر أثره في الحالة الثالثة من وجود القدرة، و هي الحالة الثانية من وجود العجز، فيجوز عندهم وقوع المقدور في الحالة الثانية، مع العجز. و كذلك لو مات القادر في الحالة الثانية، تصور وقوع المقدور مع الموت، إذ لم يكن الفعل المقدور مشروطا بالحياة. و لا يرتضي عاقل ركوب هذه الجهالة.
فإن قيل: كل صفتين متعلقتين متضادتين، فإنهما يثبتان على قضية واحدة مع التناقض في التعلق. فإذا حكمتم بأن القدرة الحادثة تقارن المقدور، فيلزمكم أن تحكموا بمقارنة العجز المعجوز عنه، و ذلك مستحيل، فإن المرء يعجز عما يتوقعه في المآل. و قد جبن بعض أصحابنا و حكم بأن العجز يتقدم على المعجوز عنه، بخلاف القدرة، و ذلك باطل: فإن العجز ينبغي أن يتعلق على حسب تعلق القدرة، مع التناقض المعتقد بين الضدين، و لذلك لا يتصور العجز عما لا يتصور الاقتدار عليه.
ص: 183
فاعلم ذلك، و اقطع بأن من قال: العبد عاجز عن الأجسام و الألوان، فهو متجوز. و المراد بالعجز المتجوز به انتفاء القدرة، و هذا كما أن الجهل ضرب من الاعتقاد. و قد يسمى الغافل عن الشي ء جاهلا به، و إن لم يكن معتقدا شيئا؛ فيخرج من ذلك أن المضطر إلى رعدته عاجز عنها معها، كما أن المتحرك على اختيار قادر على حركته مع حركته.
القدرة الحادثة لا تتعلق إلا بمقدور واحد، و قد ذهبت المعتزلة إلى أن القدرة تتعلق بالمضادات، و ذهب الأكثرون منهم إلى تعلقها بالمختلفات التي لا تتضاد. ثم أصلهم أن القدرة الحادثة تتعلق بما لا نهاية له من المقدورات على تعاقب الأوقات. و هم متفقون على أن القدرة الواحدة لا يتأتى بها إيقاع مثلين، في محل واحد جميعا في وقت واحد و إنما يقع مثلان كذلك بالقدرتين. فإن كثرت أعداد الأمثال، مع اتحاد المحل و الوقت، كثرت القدر على عدتها.
و الأولى بنا بناء هذه المسألة على التي قبلها، فنقول في منع تعلق القدرة الحادثة بالضدين: لو تعلقت بهما لقارنتهما، و من ضرورة ذلك اقترانهما، و هو باطل على الضرورة. فإن استحالة اجتماع الضدين مدركة بالبداية، و إن فرضنا الكلام في المختلفات التي لا تتضاد قلنا: لو تعلقت قدرة واحدة بكل ما يصح أن يكون مقدورا للعبد، لوجب أن تكون القدرة القادرة على الدبيب قادرة على اكتساب جميع العلوم و الإرادات و نحوها من المقدورات. و هذا مما يعلم
ص: 184
بطلانه، و يستغني فيه عن سبر نظر و تقسيم فكر. ثم البناء على المسألة المتقدمة يطرد في هذا الطرف.
فنقول: للمخالفين إذا حكمتم بأن القدرة الواحدة تتعلق بالضدين، فلم يختص أحد الضدين بالوقوع بالقدرة بدلا عن الثاني؟ فإن قالوا: إنما يقع من الضدين ما تجرد القصد إليه، و لذلك يختص بالوقوع، فهذا باطل من وجهين: أحدهما أن الغافل و النائم قد يقع منهما أحد الضدين من غير إرادة، و صلاح القدرة للواقع كصلاحها للذي لم يقع: و الوجه الثاني، أن نقول: إذا وقعت الإرادة مقدورة، و الكراهية التي هي ضد لها مقدورة أيضا، فما بال الإرادة اختصت بالوقوع، و الإرادة لا تراد عند كم؟
و لا مخلص للمعتزلة من هذا المضيق و الواقع عندنا مقدور، و لذلك وقع بخلق القدرة عليه، مع القطع بأنها لا تصلح لغير ما وقع.
و مما ألزم المعتزلة في ذلك، أن يقال لهم: الغفلة تضاد العلم؛ و لذلك يعدم العلم عندكم بطريان الغفلة كما يعدم السواد بطريان البياض، فيجب أن يكون القادر على العلم بالشي ء قادرا على الغفلة عنه، و معلوم قطعا أن الغفلة غير مقدورة. و للمعتزلة في ذلك خبط لا يحتمل هذا المعتقد ذكره.
فإن قالوا: سبيل القادر أن يتخير بين الإقدام على الشي ء و الانفكاك عنه، و إنما يتحقق ذلك عند التمكن من الضدين. و لو كانت القدرة لا تتعلق إلا بمقدور واحد، لكان العبد ملجأ إليه غير واجد عنه محيصا. و هذا الذي ذكروه دعوى محضة، و اقتصار على ذلك المذهب. فليس من شرط القدرة على شي ء
ص: 185
القدرة على تركه، و سبيل تعلق القدرة الحادثة بمقدورها كسبيل تعلق العلم بالمعلوم، و ليس من شرط تعلق العلم بالمعلوم أن يتعلق بضد له.
ثم ما ذكروه لا يستقيم منهم، مع مصيرهم إلى أن الممنوع قادر على ما منع منه. و أصلهم أن المقيد المربوط قادر على المشي و التصعد في الهواء. فإذا ساغ لهم الحكم بإثبات القدرة مع امتناع وقوع المقدور، لم يبعد منا إثبات القدرة على الشي ء من غير اقتدار على ضده.
فإن قيل: قد شاع من مذهب شيخكم تجويز تكليف ما لا يطاق، فأوضحوا ما ترتضونه منه، و أيدوه بالدليل بعد تصوير المسألة. قلنا: تكليف ما لا يطاق تكثر صوره. فمن صوره تكليف جمع الضدين، و إيقاع ما يخرج عن قبيل المقدورات. و الصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلا غير مستحيل.
و اختلف جواب شيخنا رضي اللّه عنه في جواز تكليف من لا يعلم، كالمغشيّ عليه و الميت.
و الدليل على جواز تكليف المحال، الاتفاق على جواز تكليف العبد القيام مع كونه قاعدا حالة توجه الأمر عليه، و قد أقمنا الدليل القاطع على أن القاعد غير قادر على القيام. فإذا جاز كون القيام مأمورا به قبل القدرة عليه، و إن كان ذلك غير ممكن، فلا يبقى لاستحالة تكليف المستحيل وجه.
ص: 186
فإن قيل: القيام ممكن على الجملة، بخلاف جمع الضدين؛ قيل: وقوع القيام مقدورا من غير قدرة عليه مستحيل كجمع الضدين، و إنما المأمور به قيام مقدور عليه.
فإن قيل: المأمور بالقيام منهي عن تركه؛ فلئن كان القاعد، في حال قعوده، غير قادر على القيام المأمور به، فهو قادر على القعود المنهي عنه، و هو متعلّق التكليف. و هذا أقرب وجه ذكر في ذلك، و هو على التحصيل باطل من وجهين: أحدهما أن الأمر بالترقي في السماء من تكليف المحال عند نفاته، و إن كان الاستقرار على الأرض مقدورا ممكنا، و هو ضد للترقي و التحليق في جو السماء. و الوجه الآخر أن القعود و إن كان منهيا عنه، فليس المقصود القعود، بل المقصود بالطلب ما لا قدرة عليه و هو التحلّق في جو السماء.
فإن قالوا: الأمر بالضدين ينبئ عن طلب جمعهما، و طلب الجمع يتطلب إرادة، و إرادة جمع الضدين مستحيلة؛ قلنا: هذا مبنيّ على أن المأمور به يجب أن يكون مرادا للآمر، و ليس الأمر كذلك عندنا. فإن الرب تعالى يأمر الكافر بالإيمان، و إذا كان شقيا في حكمه لا يريد منه وقوع الإيمان.
فإن قيل: ما جوزتموه عقلا، هل اتفق وقوعه شرعا؟ قلنا: قال شيخنا ذلك واقع شرعا، فإن اللّه تعالى أمر أبا لهب أن يصدق النبي و يؤمن به في جميع ما يخبر به، و مما أخبر به أنه لا يؤمن
به؛ فقد أمره أن يصدقه بأنه لا يصدقه، و ذلك جمع نقيضين. و قد نطقت آي من كتاب اللّه تعالى بالاستعاذة من تكليف ما لا طاقة به، فقال تعالى: رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ [سورة البقرة:
286]؛ فلو لم يكن ذلك ممكنا، لما ساغت الاستعاذة منه.
ص: 187
فإن قيل: بم علمتم خروج الألوان و الطعوم و نحوها عن كونها مقدورة للعباد؟ قلنا: لو كانت مقدورة لهم على الجملة لاتصفوا بالعجز عنها إذا لم يقدروا عليها، إذ المحل لا يخلو عن الشي ء و ضده. فإن قيل: ما يؤمنكم أنهم عاجزون عنها؟ قلنا: لو عجزوا عنها لأحسوا عجزهم، إذ العجز مما يحس كالعلوم و الإرادات و نحوها. و الدليل عليه أن العجز عما يجوز أن يكون مقدورا، يجب أن يكون مدركا عند انتفاء الآفات المانعة من العلوم. ثم لا يجب إدراكه لكونه عرضا، و لا لصفة أخرى سوى كونه عجزا، فيلزم إدراك كل عجز لذلك. فإذا لم يدرك عجزا عن الألوان و لا اقتدارا عليها، قطعنا بخروجها عن قبيل المقدورات. و اللّه الموفق للصواب.
ما علم الباري سبحانه أنه لا يقع من الحوادث، فإيقاعه مقدور له. و يتبين ذلك بالمثال أن إقامة الساعة مقدورة للّه في وقتنا، و إن علم أنها لا تقع ناجزة، و قد اضطرب المتكلمون في هذا الفصل، و لا محصول للاختلاف فيه عندي.
فإن المعنى بكون المعلوم الذي لا يقع مقدورا للّه تعالى أنه في نفسه ممكن، و أن القدرة عليه في نفسها صالحة له، لا يقصر تعلقها عنه حسب قصور تعلق القدرة الحادثة عن الألوان؛ فهذا المعنى بكونه مقدورا، ثم ما علم اللّه أنه لا يقع، فإنه لا يقع قطعا.
ص: 188
القدرة الحادثة لا تتعلق إلا بقائم بمحلها، و ما يقع مباينا لمحل القدرة فلا يكون مقدورا بها، بل يقع فعلا للباري تعالى من غير اقتدار العبد عليه. فإذا اندفع حجر عند اعتماد العبد عليه، فاندفاعه غير مقدور للعبد عند أهل الحق.
و ذهبت المعتزلة إلى أن ما يقع مباينا لمحل القدرة، أو للجملة التي محل القدرة منها، فيجوز وقوعه متولدا عن سبب مقدور مباشر بالقدرة. فإذا اندفع الحجر عند الاعتماد عليه، فاندفاعه متولد عن الاعتماد القائم بمحل القدرة.
ثم المتولد عندهم فعل لفاعل السبب، و هو مقدور له بتوسط السبب. و من المتولدات ما يقدم بمحل القدرة كالعلم النظري المتولد عن النظر القائم بمحل القدرة، في خبط و تفصيل طويل و اختلاف فيما يولد و فيما لا يولد؛ و ليس غرضنا التعرض لتفاصيل مذهبهم.
و الدليل على صحة ما صار إليه أهل الحق أن الذي وصفوه بكونه متولدا لا يخلو؛ إما أن يكون مقدورا، أو غير مقدور. فإن كان مقدورا، كان ذلك باطلا من وجهين: أحدهما أن السبب على أصولهم موجب للمسبب عند تقدير ارتفاع الموانع، فإذا كان المسبب واجبا عند وجود السبب أو بعده فينبغي أن يستقل بوجوبه، و يستغني عن تأثير القدرة فيه. و لو تخيلنا اعتقاد مذهب المتولد، و خطر لنا وجود السبب و ارتفاع الموانع، و اعتقدنا مع ذلك انتفاء القدرة أصلا، فيوجد المسبب بوجود السبب جريا على ما قدمناه من الاعتقادات. و الوجه الثاني أن المسبب لو كان مقدورا لتصور وقوعه دون
ص: 189
توسط السبب؛ و الدليل عليه أنه لما وقع مقدورا للباري تعالى إذا لم يتسبب العبد إليه، فإنه يقع مقدورا له تعالى من غير افتقار إلى توسط سبب.
فإن قالوا: الباري سبحانه و تعالى قادر بنفسه، و العبد قادر بالقدرة، و القادر بالنفس يخالف القادر بالقدرة، و لذلك يتصف بالاقتدار على أجناس لا يقدر عليها العباد بالقدرة؛ قلنا: هذا لا تحصيل له، فإن القدرة عندكم لا تؤثر في إيقاع المقدور شاهدا، و إنما الموقع للفعل كون القادر قادرا. ثم هذا الحكم شاهدا يعلل بالقدرة، و هو غائب غير معلل لوجوبه و امتناع تعليل الواجب عندكم. و لذلك زعمتم أن أثر كون القادر قادرا شاهدا و غائبا الاختراع، و قضيتم باختصاص العبد بمقدورات لا تتناهى، و لا يغنيكم بعد ذلك مناقضتكم أصلكم في الحكم بخروج بعض الأجناس عن مقدورات العباد. و أنتم مطالبون في ذلك بما أنكرتموه؛ فلم ينفعكم الاسترواح إلى القواعد الفاسدة و الطلبة عليكم متوجهة في التسوية بين الشاهد و الغائب في حكم المقدورات.
فإذا بطل بما ذكرناه كون المتولد مقدورا للعبد، و هو القسم الذي اعتنينا بإبطاله، و هذا يبطل مذهب كافة المعتزلة، فلا يبقى بعد ذلك إلا الحكم بكون المتولد غير مقدور؛ فإن قضى بذلك قاض كان مصرحا بأنه ليس فعلا لفاعل السبب. فإن شرط الفعل كونه مقدورا للفاعل. و إذا جاز ثبوت فعل لا فاعل له، جاز أيضا المصير إلى أن ما نعلمه من جواهر العالم و أعراضه ليست فعلا للّه، و لكنها واقعة عن سبب مقدور موجب لما عداه، و ذلك خروج عن الدين و انسلال من مذهب المسلمين.
ص: 190
ثم المصير إلى التولد، يجر على معتقده فضائح تأباها العقول، و يدرك فسادها بالبداية. و ذلك أن من رمى سهما، ثم اخترمته المنية قبل اتصال السهم بالرمية، ثم اتصل بها و صادف حيا، و لم يزل الجرح ساريا إلى الإفضاء إلى زهوق الروح في سنين و أعوام، و كل ذلك بعد موت الرامي، فهذه السرايات و الآلام أفعال للرامي و كل ذلك بعد موت الرامي و قد رمت عظامه، و لا مزيد في الفساد على نسبة قتل إلى الميت.
و كل ما دللنا به على تفرد الباري سبحانه بخلق كل حادث، فهو جار في هذا الفصل ردا على من يزعم المتولدات مخترعة لفاعل الأسباب.
فإن قالوا: وجدنا المسببات واقعة على حسب القصود و الدواعي و مبالغ الأسباب، كما أن المقدورات المباشرة بالقدرة القائمة بمحالها تقع على حسب الدواعي و القصود؛ فهذا الذي ذكروه مما نقضناه في خلق الأعمال، و أوضحنا بطلان التعويل عليه.
ثم إن ما ذكروه يبطل بما يساعدوننا على كونه غير متولد، كالشبع و الري و السقم و البرء و الموت عند معظم المعتزلة، و الحرارة عند احتكاك جسم بجسم مع تحامل و اعتماد، و سقط الزناد عند الاقتداح، و فهم المخاطب و خجله و وجله عند الأفهام و التخجيل و التخويف؛ فكل ذلك، و ما جرى مجراه، غير متولد عند الخصوم. و إن كان ما طردوه عند الوقوع على حسب القصود، مطردا فيها. فإن قالوا: ما استشهدتم به يختلف الأمر فيه، و لا يطرد على وتيرة واحدة، قلنا: فكذلك سبيل الرمي و الجرح و رفع الثقيل و شيله و كل ما يتنازع فيه.
ص: 191
ذهبت الفلاسفة إلى أن الكون و الفساد، المعبر بهما عن تركيب العناصر الأربعة و انحلالها بعد التركيب، من آثار الطبائع و القوى؛ و ما يجري في العالم المنحط عن فلك القمر و مداره، من الاستحالات الضرورية، فكلها آثار طبيعية؛ و ما يجري به في العالم العلوي العري عن النار و الهواء و الماء و الأرض، فهو من آثار نفوس الأفلاك و عقولها، ثم تلك الآثار مستندة عندهم إلى الروحاني الأول، و هو يستند إلى الموجود الأول، و هو الباري على زعمهم، و هو سبب الأسباب و موجبها.
و ليس من مقتضى أصلهم أن الموجود الأول يخترع شيئا على اختيار في إيقاعه، بل هو موجب للروحاني الأول، ثم الروحاني الأول موجب للفلك و نفسه و عقله؛ و كذلك القول في الفلك الأعلى مع الذي يليه إلى الانتهاء إلى فلك القمر، و الآثار العلوية متناسبة لا اختلاف فيها و لا يعتورها قبول اختلاف الأشكال، و الشمس لا يتصور تقديرها على هيئة أخرى غير الهيئة التي هي عليها؛ و إنما يتعرض لقبول الأشكال المختلفة، هيولى عالم الكون و الفساد و يعبرون في هذه المواضع بالهيولى عن الجواهر، و يعبرون عن أعراضها بالصورة.
ثم حقيقة أصلهم أن العالم العلوي، و عالم الكون و الفساد، لا مفتتح لهما، و هما مع الموجود الأول كالمعلول مع العلة. و الأولى أن نقيم الدلالة القاطعة
ص: 192
على حدث العالم، و كل متعرض لاعتوار الأكوان عليه، و في إثبات ذلك نقض أصلهم.
ثم كل ما ذكروه تحكم لا محصول له. و لا يزال لهم في هذه المواقف، التي يسمونها الإلهيات، اصطبار على اعتبار النظار و امتحانهم إياهم بمسالك الحجاج. و هم يعترفون بذلك،و يزعمون أن الإلهيات إنما يتوصل إليها بتهذيب القريحة، و الرياضيات التي هي خواص الأعداد و الهندسة و الطبائع و علم الألحان. و من تهذب بها قبل الإلهيات من غير حجاج.
و من عجيب أمرهم، أنهم يزرون على قواطع المتكلمين، و يزعمون أنها مغالطات و أحسن رتبها الجدليات، و ليس منها الأقيسة البرهانية؛ ثم يجتزون فيما هو المقصود بقبول الطبع له من غير حجاج، مع أنه عندهم من أخفى الخفيات. فيقال لهم: هلا اكتفيتم بالموجود الأول في إيجاب كل ما عداه؟ و ما الذي دلكم على إيجاب الروحاني الأول ثم إيجاب الروحاني ما دونه؟ و هل هذا إلا تحكم محض لا محصول له؟ و لا يحتمل هذا المعتقد أكثر من ذلك.
و أما ما سموه طبائع فيما دون فلك القمر، فلا محصول له، فإنهم عنوا بكل ما أشاروا إليه اجتماع العناصر على أقدار؛ فإن عنوا باجتماعها يداخلها فذلك محال، لأن المتحيز لا يقوم بحيث متحيز. و لو جاز قيام متحيز بحيث متحيز لجاز رجوع العالم إلى حيز خردلة، من غير تقدير عدم شي ء منها، و هذا معلوم بطلانه على الضرورة، و لو تداخلت العناصر اجتمعت في الحيز الواحد الحرارة التي هي صورة النار، و الرطوبة التي هي صورة الهواء، و البرودة التي هي صورة الماء، و اليبوسة التي هي صورة الأرض، و ذلك معلوم بطلانه
ص: 193
بضرورة العقل. فإن زعموا أن العناصر تتجاوز، و كل عنصر مختص بحيزه منفرد بصورته؛ فينبغي أن تبقى بسائط على صورها في مراكزها، و العناصر متحيزة فإنها شواغل أحياز ذوات أشكال، و هي أجزاء هيولانية على صور. فاكتفوا بذلك في هذا المعتقد
لما رأينا هذا الفصل متعلقا بأحكام الإرادة، و خلق الأعمال، و متعلقات القدر، رأينا تقديم هذه الأصول. و قد حان أن نذكر مذهب أهل الحق في إرادة الكائنات، و الرد على مخالفيهم.
فمذهبنا أن كل حادث مراد اللّه تعالى حدوثه، و لا يختص تعلق مشيئة الباري بصنف من الحوادث دون صنف، بل هو تعالى مريد لوقوع جميع الحوادث: خيرها و شرها، نفعها و ضرها.
و من أئمتنا من يطلق ذلك عاما، و لا يطلقه تفصيلا. و إذا سئل عن كون الكفر مرادا للّه تعالى، لم يخصص في الجواب ذكر تعلق الإرادة به، و إن كان يعتقده، و لكنه يجتنب إطلاقه لما فيه من إيهام الزلل، إذ قد يتوهم كثير من الناس أن ما يريده اللّه تعالى يأمر به و يحرض عليه؛ و رب لفظ يطلق عاما و لا يفصل. فإنك تقول: العالم بما فيه للّه تعالى؛ و إن فرض سؤال في ولد أو زوجة، لم تقل الزوجة و الولد للّه تعالى؛ و من حقق من أئمتنا، أضاف تعلق الإرادة إلى كل حادث: معمما و مخصصا، مجملا و مفصلا.
ص: 194
و مما اختلف أهل الحق في إطلاقه، و منع إطلاقه، المحبة و الرضا فإذا قال القائل: هل يحب اللّه تعالى كفر الكفار و يرضاه؟ فمن أئمتنا من لا يطلق ذلك و يأباه. ثم هؤلاء تحزبوا حزبين:
فقال بعضهم: المحبة و الرضا يعبر بهما عن إنعام اللّه تعالى و إفضاله، و هما من صفات أفعاله، و إذا قيل «أحب اللّه تعالى عبدا»، فليس المراد به تحننا عليه و ميلا إليه، بل المراد إنعامه على عبده.
و محبة العبد لربه تعالى إذعانه له و انقياده لطاعته، فإنه تعالى يتقدس عن أن يميل أو يمال إليه.
و من هؤلاء من يحمل المحبة و الرضا على الإرادة، و لكنه يقول: إذا تعلقت الإرادة بنعيم ينال عبدا فإنها تسمى محبة و رضا، و إذا تعلقت بنقمة تنال عبدا فإنها تسمى سخطا. و من حمل المحبة على صفات الأفعال، حمل السخط أيضا عليها.
و من حقق من أئمتنا لم يكع عن تهويل المعتزلة، و قال المحبة بمعنى الإرادة و كذلك الرضا، و الرب تعالى يحب الكفر، و يرضاه كفرا معاقبا عليه. فإذا ثبت أن المحبة هي الإرادة، فيترتب على ذلك أمر معترض في الفصل ليس من مقصوده.
و هو أن تعلم أن الرب تعالى لا تتعلق به المحبة على الحقيقة، فإن الإرادة لا تتعلق إلا بمتجدد، و الرب تعالى أزلي لا أول له؛ و إنما يريد المريد أن يكون ما ليس بكائن و يجوز كونه، و إن يعدم ما يجوز عدمه، و ما ثبت قدمه و استحال عدمه، لم تتعلق به الإرادة.
ص: 195
و الذي يكشف الحق في ذلك، أن اجتماع الضدين لما كان مستحيلا، و كانت استحالة واجبة، يمتنع أن يريد المريد استحالة اجتماع الضدين. و كذلك من اعتقد أن كون السواد سوادا واجب، فيستحيل منه أن يريد أن يكون السواد سوادا، مع اعتقاده وجوبه و تقديره استمرار الوجود له. ثم يرجع بنا الكلام إلى غرض الفصل.
قالت المعتزلة: الرب تعالى مريد لأفعاله سوى الإرادة و الكراهة و هو مريد لما هو طاعة و قربة من أفعال العباد، كاره للمحظورات من أفعالهم. و أما المباح منها، و ما لا يدخل تحت التكليف من مقدورات البهائم و الأطفال، فالرب عندهم لا يريدها و لا يكرهها.
و لنا في سبر ذلك مسلكان في العقل: أحدهما البناء على خلق الأفعال، و قد بينا أن كل خلق فاللّه عز و جل ربه و خالقه. ثم يجب من ذلك كونه تعالى مريدا لكل حادث، قاصدا إلى إيقاعه و اختراعه. و الثاني أن نخصص العقل بطرق مغنية عن البناء، مشوبة بالسمع، و موجب الشرع.
فمما يستدل به أن نقول: اتفق مثبتو الصانع تعالى على تعاليه و تقدسه عن سمات النقص و وضر القصور؛ ثم اتفق أرباب الألباب على أن نفوذ المشيئة أصدق آيات السلطان و أحق دلالات الكمال، و نقيض ذلك دليل نقيضه. فإذا زعمت المعتزلة أن معظم ما يجري من العباد، فالرب سبحانه و تعالى كاره له و هو واقع على كراهته، فقد قضوا بالقصور؛ و قالوا: أراد الرب ما لم يكن، و كان ما لم يرد، و لم تنفذ إرادته في خليقته، و لم تجر مشيئته في مملكته، و وقع كثير من الحوادث كما أراد إبليس و جنوده.
ص: 196
و للمعتزلة مراوغات في محاولة دفع ذلك، يهون مدرك جميعها و التّفصّي عنها. و نحن نذكر ما يخيلون به، و يستذلون به الطعام و العوام.
فمما ذكروه أن قالوا: الرب تعالى قادر على إلجاء الخلق و اضطرارهم إلى الإيمان، بأن يظهر آية تظل لها أعناق الجبابرة خاضعة. و إنما كان يلزم وصفه بالقصور لو لم يكن مقتدرا على سوق الخلق اقتهارا و إقسارا إلى ما أراد.
و هذا الذي ذكروه تلبيس لا تحصيل له. فإنهم مطبقون على أن الرب لا يخلق إيمان المؤمنين و طاعة المطيعين، و إنما المعنيّ بالإلجاء عندهم إظهار آيات هائلة يؤمن عندها الكفار. و الذي ذكروه لا تحصيل له؛ فإنه ربما يقع في المعلوم أن طوائف من الكفرة يصرون على كفرهم و لا يذعنون للحق، و إن عظمت الآيات، و هذا غير بعيد في جائزات العقول. و الذي يقرره أن المعتزلة قالوا: رب عبد يعلم الرب تعالى أنه ليس في المقدور لطف يفعله الباري تعالى به فيؤمن عنده، فإذا لم يكن ذلك بعيدا في اللطف، لم يبعد في الآيات المخوفة.
و الذي يقطع هذا التشغيب أن نقول: لو ألجئوا لما كان إيمانهم مثابا عليه عندكم، و لو قدر ذلك لكان قبيحا، و الرب سبحانه لا يريد القبائح على زعمكم، و إنما يريد الإيمان المثاب عليه. و من ضرورة الاختيار انتفاء الإلجاء و الاضطرار، فالذي أراده لا يقدر على تحصيله، و الذي يقدر عليه يستحيل أن يريده؛ تعالى اللّه عن قول الزائفين.
فإن قالوا: إذا جاز أن يكون ما نهى عنه و لا يكون ما أمر به، فلا يمتنع أيضا أن يقع ما يكره و لا يقع ما يريد. و هذا ساقط من الكلام؛ فإن ما لم يقع مما أمر
ص: 197
به، إنما لم يقع لأنه لم يرد أن يقع، فلم يأت عدم الوقوع من صفة غيره فيلزم قصوره؛ و إذا لم يقع ما أراد، فقد أتى قصوره الإرادة من جهة غيره. فشتان بين ما ألزمونا به، و بين ما ألزموه.
و مما يقوي التمسك به إجماع السلف الصالحين، قبل ظهور الأهواء و اضطراب الآراء، على كلمة متلقاة بالقبول غير معدودة من المجملات المتأولات، و هي قولهم: ما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم يكن.
و مما يطيش عقولهم، اتفاق العلماء قاطبة على أن المديون القادر على إبراء ذمته، إذا قال:
و اللّه لأقضين حق غريمي غدا إن شاء اللّه عز و جل، فإذا انصرم الأجل المضروب و الأمد المرقوب و لم يقضه، فلم يحنث الحالف لاستثنائه بمشيئة اللّه، و ينزل ذلك منزلة ما لو قال: لأقضين حقه غدا إن شاء زيد، ثم استبهمت مشيئته و لم يحط بها. فلو كان الرب تعالى مريدا لقضاء الدين لا محالة، لتنزل ذلك منزلة ما لو قال: لأقضين حق غريمي غدا إن شاء زيد، ثم شاء زيد و لم يقضه فيحنث لا محالة.
و مما يقوي إلزامه، أن نقول: الرب تعالى عندكم يريد إيمان الكافرين، و ذلك واجب في حكمه؛ فبينوا معاشر المعتزلة ما نسائلكم عنه و أوضحوا الوقت الذي تقرر الإرادة له، و الإرادة حادثة عندكم. فلا يكادون يضبطون في ذلك وقتا موقوتا، و لا يلقون لأنفسهم ثبوتا.
شبهة أخرى للمعتزلة فمما تمسكوا به، و في ذكره و الانفصال عنه تمهيد أصل متنازع فيه، أن قالوا: الأمر بالشي ء يتضمن كونه مرادا للآمر، و يستحيل
ص: 198
في قضية العقول أن يأمر الآمر بما يكرهه و يأباه؛ و كذلك النهي عن الشي ء يتضمن كونه مكروها للناهي، و يستحيل أن يكون الناهي على حكم الحظر مريدا لما نهى عنه. و أكدوا ذلك بأن قالوا: الجمع بين الأمر الجازم، و بين إبداء كراهية المأمور به متناقض، و هو بمثابة الجمع بين الأمر بالشي ء و النهي عنه؛ إذ لا فرق بين أن يقول القائل:
آمرك بكذا و أنهاك عنه، و بين أن يقول: آمرك بكذا و أكره منك فعله. و إذا تبين أن كل مأمور به مراد للآمر، فيخرج من ذلك كون الباري تعالى مريدا لإيمان من علم أنه لا يؤمن، لأنه آمر له بالإيمان.
و الجواب على ذلك من أوجه؛ منها أن يتبين أن ما استبعدوه، من كون الآمر كارها لما أمر به، غير بعيد شاهدا. و قد ضرب المحصلون لما نبغيه أمثلة، و نحن نجتزئ بواحد منها.
و هو أن الرجل إذا كان يؤدب عبيده، و يبالغ في ردعهم و قمعهم و يبرح بهم ضربا؛ فإذا استفاض خبره و اتصل بسلطان الوقت، و همّ بأن يزجره و يبالغ في تأديبه، فلما استحضره و بثّ إليه خبره قال معتذرا: إنما صدر مني ما صدر لاستعصاء عبيدي و تمردهم و إبدائهم صفحة الخلاف.
فاتهم السلطان أمره و لم يثق بما قاله، و بقي مستعر الصدر عليه، فرام سيد العبيد تحقيق مقالته و نفي الظن عن أحواله، و قال للسلطان: آية صدقي أني أستحضر عبيدي و آمرهم بمرأى منك و مسمع أمرا جازما تنتفي عنه جهات التأويلات؛ فإن هم خالفوني و عصوا أمري، استبان للملك صدقي؛ و إن أطاعوني، فأنا المتعرض لسخطه. فإذا استحضرهم، و أمرهم و نهاهم و زجرهم، فلا شك أنه يريد منهم أن يخالفوه ليتمهد عذره.
ص: 199
فإن قالوا: ما يصدر منه في الصورة المفروضة ليس بأمر على الحقيقة، و ليس الغرض منه اقتضاء الطاعة. قلنا: هذا جحد للضرورة فإن الأمر إذا بدر من السيد مقترنا بقرائن من أحواله قاطعة باقتضاء الطاعة، بحيث لا يستريب فيه العبيد، بل يضطرون إلى معنى الاقتضاء و موجب الطلب و الابتغاء، فكيف يمكن حمل الأمر المقترن بالقرائن على خلاف المعلوم من مقتضاه على البديهة و الضرورة؟ و كيف لا يكون الأمر كذلك، و إنما يتمهد عذر السيد إذا كان أمره جازما لا تردد في فحواه؟ و لو لم يكن الأمر كذلك، لم تقبل معاذيره، و لم يتسق تقديره.
و مما يدل على أن المأمور به لا يجب أن يكون مرادا للآمر، أصل النسخ؛ فإنه رفع للحكم بعد ثبوته، و يستحيل تقدير كون المنسوخ مرادا. فإن الواجب إذا حظر و حرّم، فيجب على أصل المعتزلة أن يعود ما كان مرادا مكروها، و ذلك غير سائغ في أحكام اللّه تعالى إجماعا، و هو دال لو ثبت على البداء، و الرب تعالى متقدس عنه. فإذا ثبت أن النسخ يصادف مأمورا به، و تقرر أن المراد لا ينقلب مكروها؛ فيخرج من مضمون ذلك، أن المأمور به أو لا لم يكن وقوعه مرادا للآمر.
فإن قالوا: النسخ لا يتضمن رفع الحكم، و إنما هو تبيين مدة العبادة على حكم التخصيص؛ فهذا الذي ذكروه رد للنسخ جملة، و التزام لمذهب منكريه من اليهود و غيرهم. و سنذكر النسخ و حقيقته، و الرد على جاحديه في النبوءات إن شاء اللّه عز و جل.
ص: 200
و مما تمسك الأئمة في أن المأمور به يجوز أن لا يكون مرادا للآمر، قصة إبراهيم و ولده الذبيح عليهما السلام. فإنه صلى اللّه عليه و سلّم أمر بذبح ولده، و لم يرد ذلك منه.
و للمعتزلة خبط في درء حجة اللّه تعالى لا يغنيهم عما أريد بهم. فمنهم من يقول: لم يكن إبراهيم عليه السلام مأمورا بذبح ولده تحقيقا، و إنما تخيل أمرا في حلمه و حسبه أمرا؛ و هذا ازدراء عظيم على الأنبياء و حط من أقدارهم. و كيف يستجيز ذو دين أن ينسب إلى إبراهيم خليل الرحمن الإقدام على ذبح ولده من غير أمر جازم؟ و كيف يسوغ أن لا يحيط ولده علما بكونه مأمورا أو غير مأمورا؟ و تجويز ذلك يسقط الثقة بما ينقلون من أوامر اللّه تعالى.
و منهم من يقول: إنما كان مأمورا بالشد و الربط و التلّ للجبين و إرهاف المدية، و التعرض لمقدمات الذبح، دون الذبح. و هذا من الطراز الأول؛ فإنا على اضطرار نعلم من اعتقاد القصة أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بذبح ولده، و من هذا عظم بلاؤه، كما قال تعالى: إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ [سورة الصافات: 106]، و افتداؤه بالذبح العظيم أعظم آية على ذلك. و لا يسوغ أن يعتقد النبي في أمر اللّه تعالى خلاف مقتضاه.
فإن قالوا: الدليل على أنه لم يكن مأمورا بالذبح، أنه لما شد يديه و رجليه رباطا، و تلّه للجبين، قيل له: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا [سورة الصافات: 105]، فدل ذلك على امتثاله مقتضى الأمر و بلوغه منتهاه. و هذا غفلة منهم و ذهول عن الحق؛ فإنه ما قيل له: «حققت الرؤيا»، بل قيل:
«صَدَّقْتَ الرُّؤْيا»، أي
ص: 201
اعتقدت صدقها و ابتدرت لما أمرت به، فانحجز الآن عن إمضاء الأمر؛ فقد رفع عنك، و فدي و لدك عن الذبح المأمور به بالذّبح العظيم.
فإن قالوا: كان إبراهيم يقطع حلقوم ولده و يفري أوداجه، و كان إذا قطع جزء التأم و التحم ما قبله، و لم يزل الأمر كذلك حتى نفذت الشفرة من الجانب الثاني، فقد أمر بالذبح و أريد منه ذلك؛ و هذا الذي ذكروه افتراء عظيم و تخرص على معنى الكتاب. فإنه تعالى قال مخبرا عنهما: فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ [سورة الصافات: 103- 104] الآية؛ فاقتضى ظاهر الخطاب أنه كما تله، نودي بالتخفيف، و افتداؤه من الدلالات القاطعة على أنه لم يمتثل ما أمر به. ثم ما نقلوه لا يسمى ذبحا، و إنما الذبح فصل الحلقوم و المري ء و فري الأوداج، مع بقائها على انفصالها إلى تتمة الذبح. فبطلت حيلهم، و اتجهت حجة اللّه عليهم.
و ما ذكروه، من تناقض الجمع بين الأمر بالشي ء و إبداء كراهيته، دعوى، و لا تناقض عندنا في الجمع بينهما. و كيف يسوغ دعوى التناقض و أمر اللّه تعالى عام تعلقه بالمكلفين، مع نصوص لا تقبل التأويل في كتاب اللّه تعالى دالة على أن اللّه تعالى لم يرد إيمان الكفرة و طاعة الفجرة؟ فإن عم الأمر تعلقا، و دلت الآيات التي نستمسك بها على أنه سبحانه أراد ضلال من ضل و هدي من اهتدى، فيبطل ذلك ما موهوا به.
و من الدليل على ذلك، أن الواحد منا لو قال لعبده: قد أزحت علتك، و قويت منّتك، و أتممت عدتك؛ حتى لا تألوا جهدا في اقتناء الخيرات، و التسرع إلى القربات، و سد الثغور؛ مع علمي قطعا بأنك تفجر و تقطع الطرق، و تسعى
ص: 202
في الأرض بالفساد، و تستعين بما أمددتك على خلاف الرشاد؛ فيعد ذلك متناقضا عرفا و إطلاقا. و الرب تعالى على أصول المعتزلة يريد صلاح من يمهله، و يعلم أنه في إمهاله يسعى على الردى و يتبع الهوى، و لو اخترم قبل حلمه لفاز و نجا. فإن لم يكن ذلك متناقضا عندهم إذا قدر في أمر اللّه، فلا تناقض فيما ادعوه.
و مما يتمسكون به كثيرا، أن قالوا: الإرادة تكتسب صفة المراد بها، فإذا كان المراد سفها كانت الإرادة سفها، و هذا من تخييلهم العريّ عن التحصيل؛ فهم مطالبون بالدليل عليه، غير مخلين بالاقتصار على محض الدعوى.
ثم لو كانت إرادة السفه سفها، لكانت إرادة الطاعة طاعة، و يلزم من مضمون ذلك أن يكون الرب تعالى مطيعا لإرادته الطاعة، و هذا خروج عن إجماع المسلمين و انسلال عن ربقة الدين. ثم الإرادة عندنا أزلية، و إنما يتصف بالسفه و نقيضه الحادث المبتدأ. و الذي يحقق ذلك أن من تكسب علما بالفواحش و فجور الفجرة، من غير حاجة ماسة إليه، فذلك سفه منه؛ و الرب تعالى عالم بجميع المعلومات خيرها و شرها، و لا يتصف في كونه عالما بما يتصف به من تكسب العلم منا.
فهذه قواعد شبههم، و في التنبيه عليها و طرق الانفصال عنها إرشاد إلى ما عداها.
ص: 203
استدل المعتزلة بظواهر من كتاب اللّه تعالى، لم يحيطوا بفحواها، و لم يدركوا معناها. منها قوله تعالى: وَ لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ [سورة الزمر: 7]. و في الجواب عن هذه الآية مسلكان: أحدهما الجري على موجبها، تمسكا بمذهب من فصل بين الرضا و الإرادة؛ و الوجه الثاني حمل العباد على الموفقين للإيمان الملهمين للإيقان، و هم المشرفون بالإضافة إلى اللّه سبحانه ذكرا. و هذه الآية تجري مجرى قوله تعالى: عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ [سورة الإنسان: 6]؛ فليس المراد جميع عباد اللّه، بل المراد المصطفون المخلصون للنعيم المقيم.
و مما يستروحون إليه قوله تعالى: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا [سورة الأنعام:
148] الآية. قالوا: فوجه الدليل من هذه الآية، أن الرب سبحانه أخبر عنه، و بيّن أنهم قالوا لو شاء اللّه ما أشركنا، ثم و بخهم ورد مقالتهم؛ و لو كانوا ناطقين بحق؛ مفصحين بصدق؛ لما قرعوا.
قلنا: إنما استوجبوا التوبيخ، لأنهم كانوا يهزءون بالدين و يبغون رد دعوى الأنبياء، و كان قد قرع مسامعهم من شرائع الرسل تفويض الأمر إلى اللّه تعالى، فلما طولبوا بالإسلام و التزام الأحكام تعلقوا بما احتجوا به على النبيين، و قالوا: لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا [سورة الأنعام: 148] الآية، و لم يكن من غرضهم ذكر ما ينطوي عليه عقدهم. و الدليل على ذلك في سياق قوله تعالى: قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ [سورة الأنعام: 148]. و كيف لا يكون الأمر
ص: 204
كذلك، و الإيمان بصفات اللّه تعالى فرع عن الإيمان باللَّه تعالى، و الكفر بالآية كفر باللَّه تعالى!.
و مما يستذلون به العوام الاستدلال بقوله تعالى: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [سورة الذاريات: 56]. و هذه الآية عامة في صيغتها، متعرضة لقبول التخصيص عند القائلين بالعموم، مجملة عند منكري العموم. و لا يسوغ الاستدلال في القطعيات بما يتعرض للاحتمال، أو يتصدى للإجمال. و من مذهب المعتزلة، أن العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا في بقية المسميات، و لا خلاف أن الصبيان و المجانين مستثنون من موجب الآية تخصيصا.
ثم قد قيل: إن المراد من الآية تبيين غنى اللّه تعالى عن خلقه، و افتقارهم إليه، فهذا هو المقصود، و آية ذلك قوله تعالى: ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ [سورة الذاريات: 57]؛ فكأن معنى الآية: و ما خلقت الجن و الإنس لينفعوني، و إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي.
ثم أصل العبادة التذلل، و الطريق المعبّدة هي المذللة بالدوس بالخف و الحافر و أقدام المستطرقين، و المراد بالآية: و ما خلقتهم إلا ليذلوا لي. ثم من خضع فقد أبدى تذلله، و من عاند و جحد فشواهد الفطرة واضحة على تذلله و إن تخرص و افترى. و الحمل على ذلك أفضل من الحمل على تناقض؛ فإن الرب تعالى علم أن معظم الخليقة يكفرون، فيكون التقدير: و ما خلقت من علمت أنه يكفر إلا ليوفق، و هذا لا وجه له.
ص: 205
و مما يستدلون به قوله تعالى: ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ [سورة النساء: 79]. قلنا: الآية المتقدمة على هذه الآية دلالة قاطعة على إبطال مذهبكم، فإنه عز من قائل قال: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً [سورة النساء: 78]. ثم لفظة الإصابة شاهدة على سلب الاختيار، فإنها لا تستعمل إلا فيما ينال المرء من غير ارتياده؛ و لا يقال أصاب فلان المشي و التصرف، بل يقال أصابه مرض أو سرور أو جنون.
ثم المراد من الآية أن كفار قريش كانوا إذا قحطوا و زلزلوا، قالوا: ذلك من شؤم محمد و دعوته، فإن وسع عليهم قالوا: ذلك منا و من آلهتنا، فرد اللّه تعالى عليهم و خاطب رسوله عليه السلام، و هم المعنيون، فقال: «ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ»، معناه من نعمة، فمن اللّه؛ و ما أصابك من سيئة، أي من ضيق، فهو جزاء عملك. على أن المعتزلة لا يقولون بظاهر الآية، إذ الخير و الشر عندهم من أفعال العباد، واقعان بقدرة العباد، خارجان عن مقدور اللّه تعالى، فهما واقعان من العبد عندهم.
و ربما يستدلون في خلق الأعمال بقوله تبارك و تعالى: فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ [سورة المؤمنون: 14]، و زعموا أن ذلك يدل على اتصاف العباد بالخلق و الاختراع، و هذا و هم منهم و زلل.
فإن الخلق قد يراد به التقدير، و من ذلك سمي الحذّاء خالقا لتقديره طاقة من النعل بطاقة، و منه قول القائل «1»:
و لأنت تفري ما خلقت ***و بعض القوم يخلق ثم لا يفري
ص: 206
و لما ذكر اللّه تعالى إجراء النطفة في أطوار الخلق، في مدد مضروبة و أوقات مرقوبة مقدرة عنده، قال تعالى: فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ. معناه أحسن المقدرين. ثم العبد عند المعتزلة أحسن خلقا من اللّه تعالى عن قولهم؛ فإن أحسن الخالقين من كان خلقه أحسن، و من خلق العبد الإيمان باللّه، و هو أحسن خلقا من خلق الأجسام و أعراضها.
ثم نتمسك بعد ذلك بنصوص الكتاب في وقوع الكائنات مرادة للّه تعالى. قال اللّه عز و جل:
وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ [سورة الأنعام: 111]، إلى قوله تعالى: ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ [سورة الأنعام: 35]؛ و قال تعالى: لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى؛ و قال تعالى: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ، وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ [سورة الأنعام: 125]. و النصوص التي استدللنا بها، عند ذكر الهدى و الضلال و الطبع و الختم، كلها دالة على ما ننتحله.
التوفيق خلق قدرة الطاعة، و الخذلان خلق قدرة المعصية؛ ثم الموفق لا يعصي إذ لا قدرة له على المعصية، و كذلك القول في نقيض ذلك. و صرف المعتزلة التوفيق إلى خلق لطف يعلم الرب تعالى أن العبد يؤمن عنده، و الخذلان محمول على امتناع اللطف. ثم لا يقع في معلوم اللّه تعالى اللطف في حق كل واحد؛ بل منهم من علم اللّه تعالى أنه يؤمن لو لطف به، و منهم من علم أنه لا يزيده ما آمن عنده غيره إلا تماديا في الطغيان و إصرارا على العدوان.
ص: 207
و يلزمهم من مجموع أصلهم أن يقولوا: لا يتصف الرب تعالى بالاقتدار على أن يوفق جميع الخلائق، و هذا خلاف الدين و نصوص الكتاب المبين، و قد قال تعالى: وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ
هُداها [سورة السجدة: 13] الآية؛ و قال تعالى: وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ [سورة هود: 118] إلى غير ذلك.
و العصمة: هي التوفيق بعينه؛ فإن عمت كانت توفيقا عاما، و إن خصت كانت توفيقا خاصا.
اتفق أهل الملل على ذمّ القدرية و لعنهم، و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم: «لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا»(1). و لا ينكر لعنهم منكر، و لكنهم يحاولون درأ هذا النبذ عن أنفسهم بما لا يغنيهم، و يقولون: أنتم القدرية إذا اعتقدتم إضافة القدرة للَّه سبحانه. و هذا بهت و تواقح، و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم: «القدرية مجوس هذه الأمة»(2). و شبههم بهم لتقسيمهم الخير و الشر، في حكم الإرادة و المشيئة، حسب تقسيم المجوس، و صرفهم الخير إلى «يزدان» و الشر إلى «أهرمن». و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه
ص: 208
و سلّم: «إذا قامت القيامة، نادى مناد في أهل الجمع: أين خصماء اللّه تعالى؟ فتقوم القدرية»(1).
و لا خفاء باختصاص ذلك بهم؛ فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى اللّه تعالى، و لا يعترضون لشي ء من أفعاله. ثم من يضيف القدرة إلى نفسه و يعتقدها صفته، بأن يتصف بالقدريّ أولى ممن يضيفه إلى ربه.
فهذه جمل مقنعة في خلق الأعمال، و الاستطاعة، و ما يتعلق بهما. و قد حان أن نخوض في أبواب التعديل و التجويز، مستعينين باللَّه تعالى، مفوضين أمورنا إليه.
ص: 209
اعلموا، أحسن اللّه إرشادكم، أن مضمون هذا الأصل العظيم و الخطب الجسيم تحصره مقدمتان و ثلاث مسائل. إحدى المقدمتين في الرد على من قال بتحسين العقل و تقبيحه، و الأخرى أنه لا واجب على اللّه تعالى يدل عليه العقل. و أما المسائل الثلاث: فإحداها في بيان مذاهب أهل الملل في إيلام اللّه تعالى من يؤلمه من عباده و خليقته، و هذه المسألة تتشعب إلى الكلام في التناسخ و الأعراض؛ و المسألة الثانية في الصلاح و الأصلح؛ و الثالثة في اللطف و معناه.
و إذا نجزت هذه الأصول، افتتحنا بعدها المعجزات، و رتبنا على ثبوت النبوات السمعيات من قواعد العقائد، و اللّه الموفق للصواب.
و كل ما ترجمناه إلى منقطع الاعتقاد، واقع في القسم الثالث من الأقسام التي رسمناها، و هو الكلام فيما يجوز في أحكام اللّه تعالى.
العقل لا يدل على حسن شي ء و لا قبحه في حكم التكليف، و إنما يتلقى التحسين و التقبيح من موارد الشرع و موجب السمع. و أصل القول في ذلك أن الشي ء لا يحسن لنفسه و جنسه و صفة لازمة له، و كذلك القول فيما يقبح و قد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة أحكام صفات النفس.
ص: 210
فإذا ثبت أن الحسن و القبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى جنس و صفة نفس، فالمعنى بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، و المراد بالقبيح ما ورد الشرع بذمّ فاعله. و ذهبت المعتزلة إلى أن التحسين و التقبيح من مدارك العقول على الجملة، و لا يتوقف إدراكهما على السمع، و للحسن بكونه حسنا صفة؛ و كذلك القول في القبيح عندهم. هذه قاعدة مذهبهم، و ربما يتخبطون فيها، و يمتنع عليهم في مجاري المذهب صرف الحسن و القبح إلى صفتين للحسن و القبيح.
و مما يجب الإحاطة به قبل الخوض في المحاجة، أن أئمتنا تجوزوا في إطلاق لفظة، فقالوا:
لا يدرك الحسن و القبح إلا بالشرع، و هذا يوهم كون الحسن و القبح زائدا على الشرع، مع المصير إلى توقف إدراكه عليه. و ليس الأمر كذلك؛ فليس الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به، و إنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله، و كذلك القول في القبيح. فإذا وصفنا فعلا من الأفعال بالوجوب أو الحظر، فلسنا نعني بما نبينه تقدير صفة للفعل الواجب يتميز بها عما ليس بواجب؛ و إنما المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به إيجابا، و المراد بالمحظور الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظرا و تحريما.
ثم المعتزلة قسموا الحسن و القبيح، و زعموا أن منها ما يدرك قبحه و حسنه على الضرورة و البديهة من غير احتياج إلى نظر، و منها ما يدرك الحسن و القبح فيه بنظر عقلي. و سبيل النظر عندهم اعتبار النظريّ من المحسنات و المقبحات بالضروريّ منها؛ بل يعتبر مقتضى القبيح و التحسين في الضروريات فيلحق
ص: 211
بها، ثم يرد إليها ما يشاركها في مقتضياتها. فالكفر عندهم معلوم قبحه على الضرورة، و كذلك الضرر المحض الذي لا يتحصل فيه غرض صحيح، إلى غير ذلك من تخيلاتهم.
و سبيلنا أن نوجه عليهم القول، فنقول: ما ادعيتم قبحه أو حسنه ضرورة فأنتم فيه منازعون، و عن دعواكم مدفوعون. و إذا بطل ادعاء الضرورة في الأصول، بطل رد النظريات إليها. و هذه الطريقة على إيجازها تهدم أصول المعتزلة في التقبيح و التحسين. و إذا تناقضت هذه الأصول، و قولهم في الصلاح و اللطف و أبواب الثواب و العقاب و غيرها متلقى منها، فينحسم عليها أبواب الكلام في فصول التعديل و التجوير.
فنقول لهم: لم ادعيتم العلم الضروري بالحسن و القبح مع علمكم بأن مخالفيكم طبقوا وجه الأرض، و أقل شرذمة منهم يزيدون على عدد أقل التواتر، و لا يسوغ اختصاص طائفة من العقلاء بضرب من العلوم الضرورية مع استواء الجميع في مداركها؟
فإن قالوا: قد وافقتمونا على التحسين و التقبيح في مواقع الضروريات، و إنما خالفتمونا في الطريق المؤدي إلى العلم، فزعمتم أن الدال على الحسن و القبح السمع دون العقل. و لا يبعد اختلاف العقلاء في العلم الضروري على هذا الوجه، فإن الأخبار المتواترة يعقبها العلم الضروري.
و قد ذهب الكعبي و أشياعه إلى أن طريق العلم بما تواترت الأخبار به و عنه الاستدلال، و ذلك لا يقدح في وقوع العلم الضروري بما تواتر الخبر عنه.
ص: 212
و هذا الذي ذكروه لا محصول له. و قد مرّ في تفصيلنا المذهب قبل ما يسقطه. فإننا قلنا ليس الحسن و القبح صفتين للقبيح و الحسن وجهتين يقعان عليهما، و لا معنى للحسن و القبح إلا نفس ورود الأمر و النهي؛ فالذي أثبتته المعتزلة، من كون الحسن و القبيح على صفة و حكم، قد أنكرناه عقلا و سمعا. و مجموع ذلك يوضح أنا لم نجتمع على المطلوب مع الاختلاف في السبيل المفضي إليه، و هذا بيّن لمن تدبره.
و مما يوضح الحق درؤهم عن دعوى الضرورة، أن الذي ادعوه قبيحا على البديهة، قد أطبق مخالفوهم على تجويزه واقعا من أفعال اللّه تعالى، مع القطع بكونه حسنا. فإنهم قالوا: إن للرب تعالى أن يؤلم عبدا من عبيده ابتداء من غير استحقاق و لا تعويض على الألم، و من غير جلب نفع و دفع ضر موفيين على الألم.
ثم كما قطعوا بتجويز ذلك في أحكام اللّه تعالى، فكذلك قطعوا بأنه لو وقع لكان حسنا، و هذا ما لا سبيل إلى دفعه، و فيه فرض تحسين العقل في الصورة التي ادعى المعتزلة العلم الضروري بالتقبيح فيها. و مهما استبان تحكمهم بدعوى الضرورة لم يسلموا ممن يعارض دعواهم بنقيضها، و يدّعي العلم الضروري بحسن ما قبحوه و قبح ما حسنوه.
فإن قالوا: الدليل على أن القبح و الحسن يدركان عقلا، أن منكري الشرائع و جاحدي النبوات يعلمون قبح الظلم و الكفران و حسن الشكر، و لو كان الأمر يتوقف في ذلك على السمع لما أحاط من أنكره بالحسن و القبح؛ و هذا
ص: 213
الذي ذكروه لا محصول له. و أول ما فيه، أنه احتجاج في موضع الضرورة على دعواهم، و لا يستمر النظر في موضع البداية.
ثم نقول: إنما يستمر لكم ما ذكرتموه، لو سلم لكم كون البراهمة «1» المنكرين الشرع عالمين بالحسن و القبيح، و هذا مما ينازعون فيه، و لا بعد في تصميم طوائف على اعتقادهم مع حسبانهم إياه
علما و إن لم يكن علما، و هذا سبيل اعتقاد المقلدين في أصول الدين.
و الذي يقرر ما قلناه، أن البراهمة كما وافقوا المعتزلة في التحسين و التقبيح العقليين على زعمهم، فكذلك اعتقدوا قبح ذبح البهائم و التسليط على إيلامها، و تعريضها للنصب و التعب. ثم اعتقادهم بذلك ليس بعلم و إنما هو جهل. و كما لا يبعد تصميمهم على جهل، فكذلك لا يبعد إصرارهم على اعتقاد ليس بعلم.
و مما يعول المعتزلة عليه في ادعاء الضرورة، أنهم قالوا: العاقل إذا سنحت له حاجة، و غرضه منها يحصل بالصدق و يحصل أيضا بالكذب يصدر عنه، و لا مزية لأحدهما على الثاني في تمكنه من جلب الانتفاع بهما و اندفاع الضرر عنه بهما؛ فإذا تساويا لديه، و تماثلا من كل وجه، فالعاقل يؤثر الصدق لا محالة و يجتنب الكذب. و إنما يختار الكذب إذا تخيل له فيه غرض زائد على ما يتوقعه في الصدق، فأما إذا تساوت الأغراض فالعقل قاض بالإعراض عن الكذب و إيثار الصدق، و ما ذلك إلا لكون الصدق حسنا عقلا.
ص: 214
و هذا الذي ذكروه باطل من وجوه: أحدها أنه روم احتجاج في موضع اتفاقهم على أنه ضروري؛ و الثاني أن ما ذكروه و صوروه متناقض؛ فإن الكذب القبيح لعينه يستحق المقدم عليه اللوم و الذم و العقاب على الجملة و الاتصاف بالدنيات و سمات النقص، و هذا موجب قول المعتزلة. فكيف يستقيم منهم تصوير استواء الصدق و الكذب، و تقدير تماثل الأغراض فيهما، و مذهبهم ما ذكرناه؟
و الذي يحقق مقصودنا، أن ما ذكروه من أن العاقل يؤثر الصدق لا محالة إذا استوت عنده الأغراض، يوجب عليهم خروج الصدق عن حكم التكليف و استحقاق الثواب على فعله و العقاب على تركه. فإن الملجأ إلى الشي ء المحمول عليه، لا ثواب له على ما هو مجبر عليه، فيجب أن يكون الصدق على قياس ما قالوه في حكم ما يجبر العاقل عليه. ثم إنما استقام لهم ما حاولوه، لطردهم كلامهم في حالة استقرار الشرائع في تقبيح الكذب و تحسين الصدق.
فإن قالوا: فرضنا الكلام فيمن ينكر الشرائع، أو فيمن لم يبلغه الشرع أصلا، فإن العاقل مع هذا الغرض يؤثر الصدق. قلنا: إنما ذلك لاعتقاد من صورتم الكلام فيه استحقاق الذم على الكذب عقلا، و ذلك محظور مجتنب؛ فإن صور ذلك فيمن لا يقول بتقبيح العقل و تحسينه، و لم يبلغه الشرع، و استوى لديه الصدق و الكذب من كل وجه؛ فلسنا نسلم، و الحالة هذه، أنه يؤثر الصدق لا محالة، بل يمتنع من إيثار الصدق و إيثار الكذب جميعا، فبطل ما موهوا به.
و مما يستروحون إليه، أن قالوا: إن الحسن لو لم يعقل قبل ورود الشرع، لما فهم أيضا عند وروده. و هذا من ركيك الكلام؛ فإنا إذا صرفنا الحسن و القبح
ص: 215
في حكم التكليف إلى ورود الأمر و النهي، فلا يمتنع العلم بالأمر إذا قدر وروده قبل وروده. و هذا بمثابة العلم بالنبوءة؛ فنعلم قبل ظهور المعجزات أن الدال على صدق من يجوز أن يبعث خوارق العادات، و نعتقد ذلك قبل اتفاق وقوع المعجزات، و دعوى النبوءات.
و ربما يشغبون بالرجوع إلى العادات و يقولون: العقلاء يستحسنون الإحسان و إنقاذ الغرقى و تخليص الهلكى، و يستقبحون الظلم و العدوان، و إن لم يحضر لهم سمع. و هذا تلبيس و تدليس؛ فإنا لا ننكر ميل الطباع إلى اللذات و نفورها عن الآلام، و الذي استشهدوا به من هذا القبيل و إنما كلامنا فيما يحسن في حكم اللّه تعالى و فيما يقبح فيه.
و الدليل على ما قلناه، أن العادات كما اطردت، على زعمهم في استقباح العقلاء و استحسانهم، فكذلك استمر دأب أرباب الألباب في تقبيح تخلية العبيد و الإماء يفجر بعضهم ببعض، بمرأى من السادة و مسمع، و هم متمكنون من حجز بعضهم عن بعض. فإذا تركوهم سدّى و الحالة هذه كان ذلك مستقبحا، على الطريقة التي مهدوها، مع القطع بأن ذلك لا يقبح في حكم الإله.
فإن قيل: هذا كلامكم في تتبع شبه المخالفين، فما دليلكم على ما ارتضيتموه؟ و لم غيرتم الترتيب و افتتحتم المسألة بذكر شبههم؟ قلنا: إنما حملنا على ذلك ادعاء خصومنا الضرورة في أصول التقبيح و التحسين؛ فلو فاتحناهم بمنهاج الحجاج، لردوه جريا على ما اعتقدوه من دعوى الضرورة في أصول التقبيح و التحسين.
ص: 216
فمن أصرّ منهم على دعواه، و هو مذهب كافتهم، فسبيل مكالمتهم ما مضى؛ و من انحط عن دعوى الضرورة احتججنا عليه، و قلنا: إذا وصف الشي ء بكونه قبيحا، لم يخل ذلك من أمرين؛ إما أن يقال: كونه قبيحا يرجع إلى نفسه أو إلى صفة نفسه؛ و إما أن يقال: إنه لا يرجع إلى نفسه، و لا إلى صفة نفسه.
فإن قيل: إنه يرجع إلى نفسه أو إلى صفة نفسه، كان ذلك باطلا من أوجه؛ أقربها أن القتل ظلما يماثل القتل حدا و اقتصاصا، و من أنكر تساوي الفعلين و مماثلة القتلين فقد جحد ما لا يجحد، و التزم انتفاء الثقة بتماثل كل مثلين. و مما يوضح فساد هذا القسم، أن ما يصدر من العاقل لو صدر من صبيّ غير مكلف، فإنه لا يتصف بكونه قبيحا مع وجوده. و منهم من ينازع في ذلك و يزعم أن الصادر من الصبيّ غير المكلف قبيح؛ فإن قالوا ذلك، التقينا بالوجه الأول.
و إذا بطل كون القبيح قبيحا لنفسه، لم يخل القول بعد ذلك؛ إما أن يقال: معنى كونه قبيحا ورود الشرع بالنهي عنه، كما صرنا إليه، و هو الحق الصراح؛ و إما أن يقال: إنما يقبح لأمر غير الشرع و غير القبيح. فإن هم قالوا ذلك، قيل لهم: إذا لم يقبح الشي ء لنفسه، و لم يحمل قبحه على تعلق النهي به، فيستحيل أن تقبح صفة لأجل صفة أخرى، و ليست تلك الصفة صفة للقبيح نفسية و لا معنوية. فثبت من مجموع ذلك بطلان تقبيح الفعل و تحسينه في حكم التكليف.
و قد تعدينا في هذا الفصل حد الاختصار قليلا، لما ألفيناه أصلا لكل ما يأتي بعده في أحكام التعديل و التجويز. و ستجدون المسائل بعد ذلك مرتبة على هذه القاعدة، و في الإحاطة بها إبطال ما سواها؛ فهذه إحدى المقدمتين الموعودتين.
ص: 217
في المقدمة الثانية، و هي تشتمل على الرد على من قال إن العقل دل على وجوب واجب، و هذا ينقسم قسمين؛ فيتعلق الكلام في أحدهما بما يقدر واجبا على العبد، و يتعلق الكلام في الثاني بالرد على من اعتقد وجوب شي ء على الباري تعالى عن أقوال المبطلين.
فأما القسم الأول، فإنه يضاهي المسألة السابقة في التقبيح و التحسين. و كل ما ذكرناه من شبههم و ادعاءاتهم الضرورة، و قدحنا فيها و احتجاجنا به، فهو يعود في هذه المسألة.
و ربما يصوغون لإثبات وجوب شكر المنعم عقلا صيغة أخرى، و يقولون: العاقل إذا علم أن له ربا، و جوز في ابتداء نظره أن يريد منه الرب المنعم شكرا؛ و لو شكره لأثابه و أكرم مثواه، و لو كفر لعاقبه و أراده؛ فإذا خطر له الجائزان، فالعقل يرشده إلى إيثار ما يؤديه إلى الأمن من العقاب و ارتقاب الثواب. و ضربوا لذلك مثلا، فقالوا: من تصدى له في سفرته مسلكان يؤدي كل واحد منهما إلى مقصده، و أحدهما خليّ عن المخاوف عريّ من المتالف، و الثاني يشتمل على المعاطب و اللصوص و ضواري السباع، و لا غرض له في السبيل المخوف، فالعقل يقضي بسلوك السبيل المأمون.
و هذا الذي ذكروه، اقتصار منهم على شطر نظر لو أنهوه نهايته لبلّغهم الحق. و ذلك أنه إن خطر له ما قالوه، فيعارضه خاطر آخر يناقضه؛ و ذلك أن يخطر للعاقل أنه عبد مملوك مخترع مربوب، و أنه ليس للمملوك إلا ما أذن له فيه
ص: 218
مالكه، و لو أتعب نفسه و أنصبها لصارت مكدودة مجهودة من غير إذن ربها. و قد يعتضد هذا الخاطر عنده بأن الرب المنعم غنيّ عن شكر الشاكرين، متعال عن الاحتياج؛ و أنه عز و جل كما يبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، لا يبتغي بدلا عليها فإذا عارض هذا الخاطر ما ذكروه، قضى العقل بتوقف من خطر له الخاطران.
و مما يؤكد ما قلناه، أن الملك المعظم إذا منح عبدا من عبيده بكسرة من رغيف، ثم أراد ذلك العبد أن يتدرج في المشارق و المغارب و يثني على الملك بحبائه و حسن عطائه و ينص على إنعامه، فلا يعد ذلك مستحسنا؛ فإن ما صدر من الملك بالإضافة إلى قدره، نزر مستحقر تافه مستصغر، و جملة النعم بالإضافة إلى قدرة اللّه تعالى، أقل و أذل من كسرة رغيف إلى ملك ملك.
و إن أردنا أن ننقض عليهم ما ذكروه من وجه آخر، فرضنا الكلام فيمن لم يحط بالمنعم أولا؛ فإذا طردوا ما قالوه من تقابل الخاطرين، قلنا لهم: هذا قولكم فيمن خطرت له الفكر و عنت له العبر، فما قولكم في الغافل الذاهل الذي لم يخطر بباله شي ء؟ فهذا قد فقد الطريق إلى العلم بالوجوب، و الشكر حتم عليه. و هذا عظيم موقعه على الخصوم.
فإن قالوا: لا بد أن يخطر اللّه تعالى ببال العاقل في أول كمال عقله ما ذكرناه، فهذا تلاعب بالدين؛ فكم من عاقل متماد في غوايته مستمر على عزته، لم يخطر له قط ما ذكروه. ثم هذه الخواطر في ابتداء النظر شكوك، و الشك في اللّه تعالى كفر، و الباري تعالى لا يخلق الكفر على أصول القوم.
ص: 219
فإن قالوا: يبعث اللّه تعالى إلى كل عاقل، ملكا يختم على قلبه، و يقول في نفسه قولا يسمعه؛ و هذا بهت عظيم، و إثبات كلام ليس بحروف، و فيه نقض أصلهم في استبعاد كلام سوي الحروف و الأصوات.
فإن أردنا تخصيص هذه المسألة بقاطع، قلنا: الرب تعالى مخترع المخترعات فلا خالق سواه، كما أوضحناه، و ما يكتسبه العبد خلق للّه تعالى؛ فلا معنى إذا في دلالة العقل على وجوب شي ء على العبد، مع استحالة إيقاعه إياه. نعم و لو طالب الرب تعالى عبده، لثبتت الطّلبة على الصفة التي ذكرناها في شبه الخصوم في خلق الأعمال. فأما إذا اعتقدنا أن العبد لا يوقع فعله، و لم يتقدم توجه طلبة عليه، فلا معنى للحكم بوجوبه، كما لا معنى للحكم بوجوب فعل الجواهر؛ فاعلموا ذلك ترشدوا، فهذا أحد قسمي الفصل.
و القسم الثاني يشتمل على نفي الإيجاب على اللّه تعالى فلا يجب عليه شي ء، و هذه المسألة شعبة من التحسين و التقبيح. و سبيل تحرير الدليل فيها أن نقول لمن اعتقد وجوب شي ء على اللّه تعالى: ما الذي عنيته بوجوبه؟ فإن قال: أردت توجه أمر عليه كان ذلك محالا إجماعا، لأنه الآمر، و لا يتعلق به أمر غيره.
و إن قال: المعنى بوجوبه، أنه يرتقب ضررا لو ترك ما وجب عليه، فذلك محال أيضا؛ فإن الرب تعالى يتقدس عن الانتفاع و التضرر؛ إذ لا معنى للنفع و التضرر، و الآلام و اللذة، و الرب متعال عنهما. فإن قال: المعنى بوجوبه، حسنه و قبح تركه، و زعم أن كونه حسنا صفة نفس له، فقد أبطلنا ذلك بما فيه مقنع.
ص: 220
ثم، مما يوجبونه على اللّه تعالى ثواب الأعمال، و سنعقد فيه بابا إن شاء اللّه عز و جل نومئ فيه إلى نكتة جارية على حسب قولهم، فنقول: أعمال العباد شكر منهم لنعم اللّه تعالى، و هو حتم عليهم عندكم، و ليس من حكم العقل استيجاب عوض على أداء فرض، و لو استوجب العبد على أداء الشكر المفروض عوضا، لوجب أن يجب للّه تعالى على العبد شكر جديد إذا أثابه، و إن كان الثواب واجبا، و هذا مما لا محيص لهم عنه أبدا. و مما يوجبونه الصلاح و اللطف، و سيأتي القول فيهما.
و هذا القدر مبلغ غرضنا في المقدمتين، و نحن الآن نبتدئ في إيلام اللّه تعالى العباد و البهائم في دار الدنيا.
الآلام و اللذات لا تقع مقدورة لغير اللّه تعالى، فإذا وقعت من فعل اللّه تعالى فهي منه حسن، سواء وقعت ابتداء أو حدثت منه مسماة جزاء. و لا حاجة عند أهل الحق في تقديرها حسنة إلى تقدير سبق استحقاق عليها أو استيجاز التزام أعواض عليها، أو روح جلب نفع أو دفع ضر موفيين عليها.
بل ما وقع منهما فهو من اللّه تعالى حسن، لا يعترض عليه في حكمه، و اضطربت الآراء على من لم يلتزم تفويض الأمور إلى اللّه تعالى.
و نحن نحكي جملا من عقود المذاهب المجانبة للحق فيها، ثم ننص على قاطع و جيز في الرد على كل فئة إن شاء اللّه تعالى. و الغرض فرض الكلام في إيلام الأطفال الذين لا يعتقدون كفرا و لم يحتقبوا وزرا، و كذلك القول في إيلام
ص: 221
البهائم.
فأما الثنوية (1) القائلون بإثبات مدبرين، فقد قالوا: الآلام ظلم قبيح لعينه على أي وجه قدر، و الآلام بجملتها صادرة عندهم من «أهرمن» دون «يزدان». و ذهبت البكرية(2)، و هم فئة منتسبون إلى بكر ابن أخت عبد الواحد، إلى أن البهائم لا تألم أصلا، و كذلك الأطفال الذين لم يعقلوا فيلتزموا بالعقل أمرا.
و ذهبت طوائف من غلاة الروافض(3) و غيرهم إلى التناسخ، فقالوا: إنما تألم البهائم لأن أرواحها كانت في أجساد و قوالب أحسن من أجساد البهائم، و قد قارفت كبائر و اجترمت جرائم، فنقلت إلى أجساد أخرى لتتعذب فيها. و إذا استوفت عقابها، و توفر عليها ما استحقته من عذابها، ردت إلى أحسن بنية.
ثم قضية أصلهم أن الرب تعالى لا يبتدئ بالآلام إلا عن استحقاق سابق، و لا يحسن الإيلام عندهم للتعويض عليه، و لا لجلب نفع به.
ثم الهياكل و الأشخاص على رتب و درجات في الرذالة و الخسة، و التعريض لفنون الآلام؛ و الأرواح منقلبة في رتبها و درجاتها، على حسب زلاتها.
ص: 222
ثم أصل هؤلاء أن جملة البهائم مكلفة، عالمة بما يجري عليها من الآلام عذابا و عقابا، و لو لم تعلم ذلك لما كانت الآلام زاجرة لها عن العود إلى أمثال ما قارفته. و صار بعضهم إلى أن كل جنس من أجناس الحيوانات، منه بني مبتعث إلى آحاد الجنس. و ذهب بعضهم إلى أنه ليس في الموجودات جمادات، و أن جملة ما يتخيلها الناس جمادات أحياء ذوات أرواح معذبة.
و اختلفت مذاهبهم في ابتداء التكليف. فزعم بعضهم أن الرب تعالى ابتدأ تكليف الأرواح، و إن تضمن ذلك إلزام مشقات و آلام. و صار صائرون منهم إلى أنه لم يبتدئ بتكليف، و لكنه فوض الخيرة إلى الأرواح، فالتزموا التكليف من تلقاء أنفسهم؛ ثم منهم من و في ما التزم و أداه، و منهم من تعداه. و ذهب ذاهبون منهم إلى أن الرب كلف الأرواح في ابتداء الفطرة ما لا مشقة فيه، ثم خالف من خالف و وفى من وفى.
و الغلاة من التناسخية «1» أنكروا الحشر و الآخرة، و قالوا: لا مزيد على تقلب الأرواح في الأجساد، على حكم العقاب، أو على حكم الثواب.
و أما المعتزلة فقد قالوا، لما سئلوا عن الآلام الحالة بالأطفال و البهائم، الآلام تحسن لأوجه:
منها أن تكون مستحقة على سوابق، و منها أن يجتلب بها نفع موف عليها برتبة بينة، و منها أن يقضي بها دفع ضرر أهم منها. و صاروا إلى أن آلام البهائم إنما حسنت، لأن الرب سيعوضها عليها في دار الثواب ما يربى و يزيد على ما نالها من الآلام. ثم صار معظمهم إلى أن العوض الملتزم على الآلام، أحط رتبة من الثواب الملتزم على التكليف. و اختلفوا في أن العوض هل يدوم دوام الثواب أم لا؟
ص: 223
و اضطربت أجوبتهم في أنه هل يتصور التفضل بمثل الأعواض ابتداء؟ فصار بعضهم إلى أن ذلك ممتنع، كما يمتنع التفضل بمثل ثواب التكليف. إذ ذاك مجمع على امتناعه، و صار من انتمى إلى التحصيل منهم إلى أن التفضل بأقدار الأعواض ممكن غير ممتنع. فمن قال بامتناع التفضل بأمثال الأعواض، جوز وقوع الآلام للتعويض المجرد؛ و من جوز التفضل بأمثال الأعواض، لم تحسن الآلام عنده لمحض التعويض، بل قال إنما يحسن بوجهين لا بد من اقترانهما: أحدهما التزام التعويض، و الثاني اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام، و كونها ألطافا في زجر الغاوي عن غوايته.
و ذهب عبّاد «2» الصيمري إلى أن الآلام تحسن بمحض الاعتبار من غير تقدير تعويض عليها.
فهذه أصول المعتزلة في إيلام البهائم و الأطفال. ثم من تمام أصلهم أن ما يحسن الألم لأجله لو علم، فإنه يحسن إذا اعتقد، أو غلب على الظن ما يحسن الآلام لأجله في عادات الناس قالوا:
و كذلك يحسن في عادات الناس العقلاء التزام المشقات، لتوقع منافع زائدة عليها و إن كانت عواقبها منطوية عن العباد، و علام الغيوب المستأثر بعلمها.
فأما الثنوية، فما قالوه من كون الألم ظلما قبيحا لعينه، باطل لا خفاء ببطلانه. فإنه نعلم أن المريض إذا شرب دواء بشيعا، كريه المشرب، و قصد بذلك درء الأمراض عن نفسه، فلا يعد ذلك في عادات العقلاء قبيحا نازلا منزلة ما لو
ص: 224
جرح السليم نفسه من غير غرض صحيح في جلب نفع أو دفع ضر. و من أنكر ذلك انتسب إلى جحد الضرورة.
ثم يقال لهؤلاء: الخير و الميل إليه مدعو إليه أم لا؟ فإن أنكروا كونه مدعوا إليه، تركوا مذهبهم، من حيث العقل على الخيرات، و تحذيره من السيئات. و إن قالوا الخير محثوث عليه، قيل لهم: هل على من يحيد عنه ملام و آلام على حكم العقاب أم لا؟ فإن قالوا: لا يلزم شرير عقابا، فقد جروا على ملابسة الشر و مجانبة الخير، و التزموا أن لا يلام مسي ء، و لا يخص بحسن الثناء عليه.
و كل ذلك يبطل ما يستروحون إليه من تحسين العقول و تقبيحها، و إن قالوا: لوم المسي ء و إيلامه، و تعريضه للغموم و الهموم حسن، فقد نقضوا قولهم بأن الألم يقبح لنفسه.
و أما البكرية، فقد جحدوا الضرورة و راغموا البديهة. فإنا على اضطرار نعلم تألم البهائم و الأطفال و قلقها عند إلمام الآلام بها، و نفورها عما تعلم أنه يؤلمها. و لو ساغ جحد ذلك منها، لساغ جحد حياتها، و المصير إلى أنها جمادات لا تحس و لا تألم و لا تدرك؛ و هذا القدر مغن في الرد عليهم.
و أما أهل التناسخ، فإنما حملهم على ما أبدعوه و شقوا به العصا أمر يلزم المعتزلة، و كلّ قائل بتقبيح العقل و تحسينه. فإنهم قالوا: الابتداء بالإيلام من غير عوض قبيح، و لا يحسن أيضا التعويض عليه مع القدرة على التفضل بأمثال العوض و أضعافه. و لا يحسن أيضا قصد اعتبار غير المؤلم، إذ يقبح إيلام
ص: 225
زيد ليعتبر عمرو؛ فلا يبقى وجه يحسّن الإيلام إلا تقديره عقابا على أمر سابق، و ذلك يستدعي لا محالة تقدم التكليف و فرض مخالفة فيه، و جريان الألم المتأخر عقابا على ما فرط.
و سنوضح توجه كلام التناسخيين على المعتزلة. و لكنا نقول لهم: ما قولكم في ابتداء التكليف؟ فإن قالوا: إن الرب تعالى ابتدأ تكليف ما في امتثاله مشقة، فقد صوروا إيلاما و آلاما من غير اجترام، و نقضوا ما أصّلوه من كل وجه. فإن راموا من ذلك مخلصا، و قالوا: إنما حسن إلزام الآلام ابتداء للثواب اللازم العظيم شأنه. فنقول لهم: هلا حسنتم إيلام البهائم و الأطفال لأعواض عليها؟ فإن قالوا: التفضل بمثل العوض جائز، و التفضل بمثل الثواب ممتنع، كان ما ذكروه تحكما؛ فإنه ما من مبلّغ إلى النعيم، إلا و الرب سبحانه قادر عليه، متفضلا و مثيبا و معوضا، و سنشير إلى ذلك عند الكلام على المعتزلة.
و إن قالوا: ما كلف اللّه العباد ما فيه مشقة، فالذي ذكروه باطل؛ بأنه لو لم يكلف العباد ما فيه مشقة لم يجز تكليف أصلا، و كان الأمر مهملا سدى. فكيف يتصور الاجترام؟ و من أي وجه استحقت الآلام؟ و كيف يستقيم ذلك ممن يبني قاعدة مذهبه على التحسين و التقبيح؟ و إن قالوا:
كلف الرب تعالى العباد ملاذّ لا مشقات فيها، قيل لهم: هذا محال؛ فإن من ضرورة الإلزام في حكم التكليف أن يعتقد المكلف لزوم ما ألزم، و في وجوب الاعتقاد عليه و إلزامه العقاب، لو لم يعتقد لزوم ما ألزمه، تعريضه لمشقة لا خفاء بها.
ثم الغرض من التكليف، التعرض للثواب. و إنما يحسن في العقل على أصل التحسين الإثابة على مشاق من الأعمال؛ فإن جاز حزم حكم العقل في الإثابة
ص: 226
على لذات عرية عن المشاق، ساغ أيضا نقض ما أصلوه بناء على تقبيح العقل الإيلام.
فإن قالوا: فوض الرب تعالى إلزام التكليف إلى خيرة الأرواح، قيل لهم: إذا قبح الألم من غير استحقاق، قبح التعريض له و التخيير فيه، و لا محيص لهم عما ألزموه.
ثم لنا بعد ذلك مسلكان: أحدهما، نسبتهم إلى جحد الضرورة في قولهم: إن البهائم تعقل، و يدعوها نبيها فتفهم تبليغ الرسالة. و ذلك جحد للضرورة؛ فإن مجوز ذلك يجوّز أن تكون الذباب و الديدان مفكرة في دقائق العلوم، يفهم بعضها من بعض التعريض للحجاج و الاستدلال و السؤال و الانفصال، و ذلك أمر هزء لا يلتزمه لبيب. و المسلك الثاني، أن تثبت عليهم الشرائع إن لم ينقلوها، فإذا ثبتت الشرائع ترتب عليها بطلان مذاهبهم المجانبة لموارد الشرع. فهذا القدر كاف في محاولة الرد عليهم.
و أما المعتزلة، فقد ذكرنا أنهم صاروا إلى أن الإيلام يحسن لوجوه، و لو عري عنها و عن آحادها، لكان قبيحا. و نحن الآن نتعقب تلك الوجوه بالنقض و الرفض واحدا واحدا.
فأما قولهم: الألم يحسن بكونه عقابا على أمر فارط، فهم فيه منازعون، و إلى الدليل عليه مدعوّون. فيقال لهم: لم قلتم إن الألم يحسن إذا كان عقابا؟ فإن قالوا: إنما قلنا ذلك لقضاء العقل بأن من ظلم و بغي عليه و أولم ابتداء أو اعتداء، فيحسن منه الإنصاف ممن ظلمه و عدا عليه. و إذا أساء العبد أدبه، لم
ص: 227
يقبح عند العقلاء زجره. قلنا: ثم تنكرون على من يزعم أن ذلك إنما لم يقبح لاستفادة المنتصف بانتصافه، شفاء غليله و درء الحنق و المغايظ عن نفسه، فيرجع ذلك في التحصيل إلى دفع ألم بألم. و كلامنا في إيلام الرب تعالى من شاء مع استغنائه عنه، و تعاليه عن الحنق و الغيظ و الاحتياج إلى تبريد الغليل. فهلا قلتم: لا يحسن منه الألم مع استغنائه عنه و عدم احتياجه إليه، و لا يجري حكمه في ذلك مجرى حكم العباد! و هذا مما لا محيص لهم منه.
فإن قالوا: الرب تعالى و إن كان غنيا عن معاقبة المجرمين، فلو ترك معاقبتهم لكان ذلك إغراء بالفواحش و ارتكاب الجرائر و الكبائر. و هذا الذي ذكروه يبطل عليهم بقبول التوبة؛ فإنه حتم في حكم اللّه تعالى عندهم، و فيه إغراء بالذنب فإن مقارفه يتجرأ عليه لاعتقاد قبول توبته عن حوبته إذا تاب و أناب. و سنعود إلى ذلك في باب الثواب و العقاب. و هذا القدر كاف في غرضنا في هذا الوجه.
و أما قولهم: إن الألم يحسن للتعويض عليه بنعيم يربى عليه، فباطل من وجهين.
أحدهما، أن الرب تعالى قادر على التفضل بمثل ما يصدر عوضا، فلا غرض في تقديم ألم و تعويض عليه مع القدرة على التفضل بمثله. و سبيل ذلك كسبيل من يؤلم ضعيفا ليعطيه رغيفا، مع اقتداره على التفضل بمثله ابتداء. و هذا آكد في حكم اللّه تعالى؛ فإن القادر على الكمال الذي لا يتعاظم عنده عطاء و لا يكثر في حكمه حباء، و العبد عرضة للضرر و ضيق العطن، و التضرر بما يبذله و إن قل.
ص: 228
فإن قال قائل منهم: لا يجوز التفضل بمثل العوض، فقد باهت. فإن الأعواض نعيم منقطع، أو مقيم دائم. و على أيّ وجه فرض، فهو مقدور للّه تعالى من غير تقدير تقديم إيلام. فإن قالوا: لو جاز التفضل بمثل العوض، لجاز التفضل بمثل الثواب. قلنا: هذا ما نعتقده، و نرد على من حاد عنه. و لهم في ذلك خبط يأتي الشرح عليه في باب الثواب و العقاب إن شاء اللّه عز و جل.
و الوجه الثاني في إبطال تحسين الألم بالتعويض، أن نقول: إذا جنى العبد على غيره و آلمه بقطع أو جرح أو غيرهما، و التزم على الألم عوضا وافيا من غير استئمار و استيذان من المؤلم، فينبغي أن يحسن ذلك منا حسب حسنه من اللّه تعالى، فإن المعتزلة يقيسون أحكام اللّه تعالى في أفعاله على أحكام العباد.
فإن قالوا: إنما يحسن الألم من اللّه تعالى لعلمه بالتمكن من التعويض عليه، و العبد لا يحيط علما بعواقب أمر نفسه، فليس له أن ينجز ألما لأمر لا يعلم الوصول إليه. و هذا باطل؛ فإن للعبد أن يؤلم نفسه في ترقب منفعة موفية على ما يناله من النصب و التعب، و إن كان ذلك مظنونا و لم يكن معلوما يقينا. فإذا حسن منه ذلك في نفسه مع انطواء العاقبة عنه، حسن ذلك في غيره.
فقد بطل ما حاولوا به الفصل بين حكم اللّه تعالى و حكم العبد. و من أحاط بما قدمناه علما هان عليه التسرع إلى دفع كل سؤال يوردونه مما لم نذكره.
و أما الوجه الثالث في تحسين الألم، و هو أن يدفع به ضررا أعظم منه، فباطل لا محصول له في حكم اللّه تعالى. فإنه ما من ضرر يقدر اندفاعه بالألم، إلا و الرب تعالى مقتدر على دفعه دون ذلك الألم، فليس في الإيلام إذا غرض
ص: 229
صحيح، و سبيل ذلك كسبيل من يتمكن من درء ضرر سبع ضار عن صبي، بأن يكلفه سلوك سبيل و طيّ لا و عورة فيه، فلو كان الأمر كذلك، فلا يحسن و الحالة هذه تكليف سلوك سبيل مشوك ضرس حزن.
و من قال منهم: إن الألم لا يحسن بمحض التعويض حتى ينضم إليه قصد اعتبار الغير، فقد أحال فيما قال. فإن العقل إذا لم يحسّن إيلام شخص لوجه، لم يحسّنه مع اعتبار غيره، إذ ليس من نصفه الحكم إتعاب شخص لاعتبار غيره. فإن قالوا: إنما يلزم ذلك لو جوزنا الإيلام بمحض الاعتبار، قلنا: هذا لا ينجيكم عما أريد بكم، فإن العوض المحض إذا لم يخرج الألم عن كونه ظلما، فوجوده كعدمه و يبقى الاعتبار في حكم المجرد، و الذي يوضح ذلك، أن من أعلمه نبي أن في إيلامه اعتبارا لغيره، فليس له أن يؤلمه و يلتزم العوض، و يحصل الاعتبار المعلوم عنده بإخبار الصادق المستيقن صدقه.
فهذه وجوه الرد على المعتزلة على قدر غرضنا من هذا المعتقد، و كل ما تكلمنا به على هذه الطوائف مبني على أتباعهم في فاسد معتقدهم. و لو لزمنا أصلنا في نفي تقبيح العقل و تحسينه، ففي التمسك به نقض جميع ما أصّلوه.
و قد نجز هذا الأصل، و هو الكلام في الآلام و حكمها من الحسن و القبح، و اللّه المستعان.
و ها نحن الآن خائضون في الصلاح و الأصلح، و نمزج به اللطف، و إن ميزنا بينهما عند رسمنا ترجمة الأصول.
ص: 230
اختلفت مذاهب البغداديين و البصريين من المعتزلة في عقود هذا الباب، و اضطربت آراؤهم.
فالذي استقرت عليه مذاهب قادة البغداديّين، أنه يجب على اللّه، تعالى عن قولهم، فعل الأصلح لعباده في دينهم و دنياهم، و لا يجوز في حكمته تبقية وجه ممكن في الصلاح العاجل و الآجل، بل عليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح عباده.
و قالوا: على موجب مذاهبهم ابتداء الخلق حتم على اللّه عز و جل و واجب وجوب الحكمة، و إذا خلق الذين علم أنه يكلفهم، فيجب إكمال عقولهم، و أقدارهم و إزاحة عللهم. و كل ما ينال العبد في الحال و المآل، فهو عند هؤلاء الأصلح لهم، حتى ارتكبوا على طرد أصلهم جحد الضرورة. و قالوا: خلود أهل النار في الأغلال و الأنكال أصلح لهم من الخروج من النار، و كذلك الأصلح للفسقة في دار الدنيا أن يلعنهم اللّه، و يحبط أعمالهم، و يحبط ثواب قرباتهم إذا اخترموا قبل التوبة.
و أما البصريون، فقد أنكروا معظم ذلك، مع موافقتهم إخوانهم في الضلال على إثبات واجبات على اللّه تعالى و تقدس عن قولهم.
فمما اتفق الفئتان على وجوبه الثواب على مشاق التكليف و الأعواض على الآلام غير المستحقة، و أجمعوا على أن الرب تعالى إذا خلق عبدا و أكمل عقله فلا يتركه هملا، بل يجب عليه أن يفكره و يمكنه من نيل المراشد، فإذا كلف عبدا
ص: 231
وجب في حكمته أن يلطف به، و يفعل أقصى ممكن في معلومه، مما يؤمن و يطيع المكلف عنده، على ما سنذكره في اللطف فصلا مفردا إن شاء اللّه عز و جل.
و نقل أصحاب المقالات عن هؤلاء مطلقا، أنه يجب على اللّه تعالى فعل الأصلح في الدين،و إنما الاختلاف في فعل الأصلح في الدنيا. و هذا النقل فيه تجوز، و ظاهره يوهم زللا، و قد يتوهم المتوهم أنه يجب عند البصريين الابتداء بإكمال العقل لأجل التكليف، و ليس ذلك مذهبا لذي مذهب منهم. و الذي ينتحله البصريون، أن اللّه تعالى متفضل بإكمال العقل ابتداء، و لا يتحتم عليه إثبات أسباب التكليف، فإذا كلف عبدا فيجب بعد تكليفه تمكينه و إقداره، و اللطف به بأقصى الصلاح؛ فهذا معنى قول الأئمة في نقل مذهبهم.
و مما اتفقوا على وجوبه إحباط الطاعات بالفسوق، و قبول التوبة، إلى غير ذلك مما استقصيناه في الشامل.
و غرضنا الآن أن نقيم واضح الدلالة على البغداديين فيما غلوا به. فإذا أوضحنا الرد عليهم، انعطفنا على البصريين، و لبسنا فريقا بفريق بسبيل التحقيق. حتى إذا التبسا، استبان الموفّق خلوص الحق من خبطهم، و اللّه المعين.
فمما نستدل به على البغداديين، بعد أن نسلم لهم جدلا تقبيح العقل و تحسينه، أن نقول:
مقتضى أصلكم، أنه يجب على اللّه تعالى أقصى ممكن في كل استصلاح، فإذا روجعتم فيما انتحلتموه، فزعتم إلى أمثلة في الشاهد توهمتهم فيها قبحا و حسنا مدركين عقلا، و حاولتم بعد اعتقاد ذلك ردّ الغائب إلى الشاهد، فإذا كان هذا مذهبكم، فينبغي أن توجبوا على الواحد منا أن يصلح غيره
ص: 232
بأقصى الإمكان، مصيرا إلى وجوب فعل الأصلح شاهدا و غائبا؛ فإذا لم توجبوا فعل الأصلح شاهدا، و هو الأصل المرجوع إليه فيما يناقش فيه غائبا، فقد نقضتم دليلكم و حسمتم سبيلكم.
و نفرض ما ذكرناه في استصلاح العبد نفسه، و قد وافقونا على أنه لا يجب على العبد أن يسعى في حق نفسه فيما هو الأصلح له في باب الدنيا، مع أنه يتمكن من جلب منافع و لذات سوى ما هو ملتبس بها.
فإن قالوا: إنما لم يجب على العبد فعل الأصلح في حق نفسه و في حق غيره، لأنه يصير بتكليف ذلك مكدودا مجهودا، فجاز أن لا يكلّف الأقصى و النهاية القصوى؛ و ليس كذلك حكم الباري تعالى فإنه مقتدر على نفع غيره و إصلاحه، مع تعاليه عن تضرر فيما يفعل. و هذا الذي ذكروه لا محصول له، فإن التعرض للنصب و التعب لو كان فاصلا بين الشاهد و الغائب فيما ألزمناهم، لوجب الفصل به فيما يجب على العباد اتفاقا، حتى يقال: لا يجب على العبد شي ء مما يكابده من المشاق.
فإن قالوا: ما يناله من ثواب الطاعات يربى على ما يناله من المشقات؛ قيل لهم: فاسلكوا هذا المسلك في جلب الأصلح في موضع الإلزام، و لا تسقطوا وجوب ما طولبتم به بالتعرض للمتاعب، و هذا ما لا مخرج منه.
ثم نقول: العبد بالتزام الأصلح أحق على فاسد أصولكم، و ما ذكرتموه في روم الفصل يقضي بضد ما ذكرتموه، فإن مكابدة المشقة تجر إلى من يقاسيها ثوابا جزيلا، فيحصل الأصلح عاجلا، و الثواب على المشقات آجلا. و الرب تعالى لا
ص: 233
يتقرر فيه الاتصاف بنصب، و لا يحسن التكليف مع اشتماله على المشقات عندهم إلا لما ذكرناه. فقد لزمهم الجمع بين الشاهد و الغائب لزوما لا محيص عنه.
و مما نعتصم به، و هو يداني ما ذكرناه، أن نقول: النوافل و القربات المتطوع بها في فعلها صلاح للعباد، و الذي يحقق ذلك دعاء الرب تعالى إليها و حثه عليها، و لا يندب الرب تعالى إلا إلى الصلاح عند هؤلاء. فإذا وضح كون فعلها إصلاحا، فليجب على العباد ما يصلحهم؛ و إذا لم يكن الأمر كذلك، و انقسم فعل العبد إلى ما يجب عليه، و إلى ما يندب إليه على الاستحباب من غير إيجاب، فلتنقسم أفعال اللّه إلى ما يجب عليه و إلى ما يعد تفضلا. فإن راموا فصلا بين الشاهد و الغائب بما ذكرناه، أجبنا بما قدمناه.
و إن قالوا: إنما قسم الرب تعالى الأحكام إلى الإيجاب و الاستحباب، لأنه علم ذلك صلاحا، و وقع في معلومه أنه لو قدر القربات بأسرها واجبات لكفر العباد، و نفروا عن أعباء التكليف، و جنحوا إلى الدعوة و التخفيف، فقدر اللّه تعالى ما هو الأصلح؛ قلنا: هذا تمويه، يدحضه أدنى تنبيه؛ إذ فعل النوافل صلاح مدعوّ إليه، و لا سبيل لهم إلى إنكار ذلك.
و لا ينفعهم بعد تسليمهم هذا، ما استروحوا إليه من اعتبار الوقوع في المعلوم، فإنهم لا يعتبرون في وجوب الأصلح عندهم حكم العلم. و لذلك قالوا: من علم اللّه تعالى أنه لو كلف لطغى و بغى و نفر و أشر و استكبر، و لو اخترمه قبل كمال عقله لفاز و نجا، فيجب على اللّه تعالى تعريضه للدرجة السنية مع علمه بأنه يعطب دون دركها. فهلا قالوا: لما كان فعل العقل صلاحا وجب
ص: 234
إيجابه، من غير اكتراث بما يقع في المعلوم! و لا مخرج من ذلك. و لهم على كل طريق مراوغات لا يخفى فسادها على من أحاط علما بمضمون هذا المعتقد، و إنما ننص على كل طريقة على أغمض ما يموهون به.
و مما يعظم موقعه على هؤلاء، أن نقول: قضاؤكم بوجوب الأصلح على اللّه، ورّطكم في جحد الضرورات. و ذلك أن الكتاب إذا بلغ أجله، و طوق كل امرئ عمله، و صار الكفار إلى الخلود في النار، و على الرب تعالى أن يصلح عباده، فإن الصلاح لأصحاب النار في خلودهم و تقطع جلودهم، و معاطاة الزقوم بدلا من السلسبيل و الرحيق المختوم.
فإن قالوا: ذلك أصلح لهم من الكون في الجنان، سقطت مكالمتهم و تبين عنادهم. و إن قالوا: إنما يخلدهم اللّه في العذاب الأليم علما منه بأنه لو أنقذهم لعادوا لما نهوا عنه، و استوجبوا مزيد عقاب على ما هم ملابسون له، فتقريرهم على ما هم فيه أصلح من تعريضهم لما يربى عليه من العذاب. و هذا ما لا محصول له.
و قد أكثروا في الجواب، و نحن نجتزئ مما أورد الأئمة بأن نقول: هلا أماتهم؟ أو هلا قطع عذابهم و سلب عقولهم حتى لا يعصوه؟ إذ ليست تلك الدار دار تكليف، فيجب فيها التعريض للتكليف. ثم إن لم يبعد المصير إلى أن الأصلح تكليف من علم الرب تعالى أنه يكفر، فهلا قيل:
الأصلح إنقاذ من علم الرب تعالى أنه يعود، و هذا أقرب؛ فإن الإنقاذ من العذاب روح ناجز، و التكليف في حق من يكفر تنجيز مشقة من غير ارتقاب ثواب. و ستكون لنا عودة إلى إلزام المعتزلة تأقيت الثواب و العقاب إن شاء اللّه عز و جل.
ص: 235
و مما نعتضد به أن نقول: إذا حكمتم، بأن كل ما يفعله الرب تعالى لا يستوجب على شي ء من أعماله شكرا و حمدا، كما لا يستوجب بإيصال الثواب إلى مستحقه حمدا في الدار الآخرة. إذ العقل على قياسهم يقضي بأن من يؤدي واجبا لا يستحق عليه شكرا، كالذي يردّ وديعة أو دينا لازما.
فإن قالوا: الثواب عوض، و ليس على العوض عوض، و ليس كذلك الابتداء بالنعمة. قلنا:
إذا استويا في الوجوب و الحتم، لم يؤثر افتراقهما فيما ذكرتموه، ثم شكر العبد عوض من النعم، و هو مقابل للثواب، فبطل التعويل على ما ذكروه من كل وجه.
و مما كثر فيه خبط البغداديين، أن قيل لهم: قد أوجبتم على اللّه تعالى فعل الأصلح في الدنيا، و مقدورات الباري تعالى لا تتناهى في اللذات، فبأيّ قدر تضبطونه في الأصلح، و لا حصر للذات و لا نهاية للمقدورات، و كل مبلغ من الإحسان فعليه مزيد من الإمكان؟
فإن قالوا: يتقدر الأصلح في حق العبد بما علم الرب تعالى أن المزيد عليه يطغيه، قلنا:
اللذات منافع ناجزة، و لا معوّل على العلم بأن العبد سيطغى، فإن من علم الرب تعالى أنه إذا أقدره خيره، فإنه يؤثر الفسوق و العصيان، فتكليفه حتم على مذاهبكم، لكونه تعريضا لمنفعته، مع العلم بأن المكلف يعطب و يشفي على الردى، فهلا طردتم ذلك في اللذات من غير تمسك بما يعلم في المآل! و لا جواب عن شي ء من ذلك.
ص: 236
و فيما صار إليه هؤلاء خرق إجماع الأمة و مخالفة الأئمة؛ فإنهم إذا أوجبوا فعل الاستصلاح فلا يبقى للإفضال مجال، و يخرج الرب تعالى عن كونه متفضلا تعالى اللّه عن قول المبطلين. و قد علمنا على الضرورة أنباء فحوى خطاب الشرع عن كون الرب متفضلا، على من يشاء، كافا نعمه عمن يشاء. و ليس للّه عند المعتزلة خيرة في أفعاله و إفضاله، و هذا قدح منهم في الإلهية، و مراغمة الكتاب العزيز. قال اللّه تعالى، في استيثاره و اختياره و قهر عباده و اقتداره: وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ [سورة القصص: 68]. و نبذة مما ذكرناه تنقض دعائم المعتزلة و تفض شكائمهم.
فأما البصريون، فإن ناجزناهم على الأصل الأول، و منعناهم تحسين العقل و تقبيحه، و أوضحنا أن لا واجب على اللّه تعالى، ففي ذلك صدهم عن مرامهم، و إن نحن أضربنا عن ذلك،و قدرنا تسليمه جدلا، قلنا لهم بعده: قد أوجبتم بعد التكليف الأصلح في الدين، فهلا أوجبتم الأصلح في أمر الدنيا! و أيّ فصل بينهما بعد الاختراع و خلق الملاذ و الشهوات؟
و نطرد عليهم شبهة للبغداديين يصعب عليهم موقعها، فنقول: مآخذكم العقول، و الرجوع إلى الشاهد. و معلوم أن من كان يملك بحارا لا تنزف و أودية خرارة غزيرة لا تنقطع، و لا حاجة به إليها؛ و بمرأى منه إنسان يلهث عطشا، و جرعة ترويه، فلا يحسن أن يحال بينه و بين ما يسد رمقه، و يقبح أن يجلي عن مشرع الماء، و إن لم يقبح ذلك فلا قبيح في العقل.
و الغرض من مساق هذا الكلام أن الأصلح في الدنيا بالإضافة إلى مقدور اللّه تعالى، أقل من غرفة ماء بالإضافة إلى البحار، فإنها متناهية و مقدورات اللّه
ص: 237
تعالى لا تتناهى، و الواحد منا لا يتضرر بالبذل، و إن قلّ و غمض مدرك ما يخصه من الضرر، و الرب تعالى منزه عن قبول الضرر.
و هذا يلزم المعتزلة إذا حسّنوا بالعقول و قبحوا، و إن ألزمنا ما قالوه نقضناه على الفور بعقاب أهل النار، و قلنا: إذا أساء العبد شاهدا حسن العفو عنه في مكارم الأخلاق، مع تعريض السيد لضرر المغايظ عند ترك الانتقام و التشفي، فما بال العصاة مخلدون في الأنكال و الأغلال، و قد ندموا على ما قدموا، و الرب تعالى أرحم الراحمين؟
و مما يخص به البصريون فيه إيضاح باب يمكن إفراده. و هو أن نقول: قد أوجبتم بعد التكليف الأصلح في الدين، و حسّنتم التكليف لتعريضه المكلف للثواب الدائم، فإذا علم الرب تعالى أنه لو اخترم عبده قبل أن يناهز حلمه لكان ناجيا، و لو أمهله و أرخى طوله، و أقدره، و سهل له النظر و يسره لعند و جحد، فكيف يستقيم أن يقال أراد الرب الخير لمن علم ذلك منه؟ أم كيف يستجيز لبيب أن يقال الأصلح تكليفه، و لو اخترم لكان قد فاز؟ و عند ذلك تحق الحقائق، و تضغطهم المضايق.
و ها نحن نوضح الحق في هذا المجال بضرب مثال، فنقول: إذا علم الأب الشفيق أن ولده لو أمدّه بالأموال لطغى و آثر الفساد و تنكب الرشاد، و لو أقتر عليه لصلح؛ فلو أراد استصلاح ولده، فأمده بالمال، مع علمه بأنه يطغيه أو يرديه، فباضطرار نعلم أن التقتير أصلح له من السعة. و لو قال الوالد، و قد أمد ولده، و هيأ له عدده، و أحسن صفده: إنما قصدت أن أقيم أوده، مع علمي بخلاف ذلك، فلا خفاء بخروجه عن موجب العقل.
ص: 238
فإن قالوا: إنما لا يكون الأب ناظرا له، لأنه لا يحيط بمبلغ ما يعرضه له من الخير لو رشد في المآل، و الرب تعالى عالم بمبلغ ما يستوجبه المكلف من الثواب لو آمن. و هذا تلاعب بالدين؛ فإن العلم بمبلغ الثواب لا حكم له مع العلم بأنه لا يناله، فما يغني العبد علم الرب بمبلغ ثواب لا يناله.
و الذي يوضح الحق في ذلك، أنه يحسن من النبي عليه الصلاة و السلام الدأب على دعاء من أعلمه الرب تعالى أنه لا يؤمن، و إن كان النبي صلى اللّه عليه و سلّم ذاهلا عن مبلغ الثواب الذي يتعرض المكلف له.
و الذي يعضد ما قلناه، أن التكليف في حق من علم الرب تعالى أنه يكفر لو كان خيرا، لحسن ممن لم يبلغ مبلغ التكليف، و علم أنه لو بلغه لكفر، أن يرغب إلى اللّه تعالى في أن يبقيه حتى يكفر،إذ حق العبد أن يرغب إلى اللّه تعالى فيما هو الأصلح له، و عند ذلك يبطل القدر رأسا على أصول المعتزلة.
و مما نخاطب به البصريين أن نقول: الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب، فأي غرض في تعريض العباد للبلوى و المشاق و البلاء؟ فإن قالوا: لا يتصف الرب تعالى بالاقتدار على ذلك، فإنا لو قدرنا ذلك لكان الرب تعالى متفضلا به، و استيفاء الحق المستحق أولى من قبول الفضل.
قلنا: هذا قول من لم يقدر اللّه حق قدره، و ما ذكرتموه إنما يؤول إلى نفي قبول المنن، و ذلك بين الأكفاء و الأضراب، و من الذي يستكبر، و هو عبد مربوب، من قبول فضل اللّه؟
و الدليل عليه أن الرب تعالى متفضل، بابتداء التكليف عندكم معاشر البصريين، فالثواب مترتب على ما اللّه تعالى متفضل بأصله. ثم نقول: نسيتم أصولكم في الرجوع إلى الشاهد. و معلوم أن ملكا في زماننا لو تفضل على
ص: 239
واحد، و أكرم مثواه، و أجزل جائزته، و أعلى رتبته، و استأجر أجيرا ثم وافاه أجره بعد عرق الجبين و كدّ اليمين، فالمتفضل عليه أحق بكونه محظوظا مرعيا ملحوظا؛ و سنعود إلى ذلك إن شاء اللّه عز و جل.
ثم نقول: العجب كل العجب ممن يقول تعريض من يكفر للهلاك أصلح له من التفضل عليه! و لا مزيد على ذلك في عمى البصائر، و قانا اللّه البدع.
اللطف عند المعتزلة، هو الفعل الذي علم الرب تعالى أن العبد يطيعه عنده، و لا يتخصص ذلك بجنس، و رب شي ء هو لطف في إيمان زيد، و ليس بلطف في إيمان عمرو.
و قد يطلق اللطف مضافا إلى الكفر، فيسمى ما يقع الكفر عنده لطفا في الكفر. ثم من أصل المعتزلة أنه يجب على اللّه تعالى أقصى اللطف بالمكلفين، و قالوا على منهاج ذلك: ليس في مقدور اللّه تعالى لطف لو فعله بالكفرة لآمنوا، تعالى اللّه عن قولهم علوا كبيرا.
و أما أهل الحق، فاللطف عندهم خلق قدرة على الطاعة، و ذلك مقدور للَّه تعالى أبدا. فنقول للمعتزلة: لم أوجبتم اللطف في الدين؟ و هلا قلتم إنه يقطع اللطف تعظيما للمحنة، و تعريضا للمكلفين لعظم المشقات، و قطع الألطاف تعريض للثواب الأجزل؟
ص: 240
فإن قالوا: الغرض أن يؤمنوا، قلنا: فأي غرض في تكليف من لا يؤمن؟ و إذا حكمنا العقول فاخترام من هذه سبيله هو اللطف به، دون تعريضه للتكليف، مع العلم بأنه لا لطف في المعلوم يؤمن المكلف عنده؛ فهذا مبلغ غرضنا في الصلاح و الأصلح و اللطف.
ص: 241
إثبات النبوءات من أعظم أركان الدين، و المقصود منه في المعتقد يحصره خمسة أبواب:
أحدها إثبات جواز انبعاث الرسل ردا على البراهمة؛ و الثاني المعجزات و شرائطها، و فيه تبيين تمييزها من الكرامات و السحر، و ما يتميز به مدعي النبوءة؛ و الثالث في إيضاح وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول؛ و الرابع في تخصيص نبوة نبينا محمد صلى اللّه عليه و سلّم بالآيات، و الرد على منكريها من أهل الملل؛ و الخامس الكلام في أحكام الأنبياء. و ما يجب لهم و ما يجوز عليهم.
قد أنكرت البراهمة النبوءات، و جحدوها عقلا، و أحالوا ابتعاث بشر رسولا. و نحن نذكر ما يعتقدونه من شبههم، و نتفصى عنها أولا. فمما يسترحون إليه أن قالوا: لو قدرنا ورود نبي لم يخل ما جاء به من أن يكون مستدركا بقضية العقل، أو لا يكون مستدركا بها. فإن كان ما جاء به مما يوصل العقل إليه، فلا فائدة في ابتعاثه، و ما يخلو عن غرض صحيح عبث و سفه، و إن كان ما جاء به مما لا يدل عليه العقول، فلا يتلقى بالقبول، فإنما المقبول مدلول العقول.
ص: 242
و شبه البراهمة مبنية على تحسين العقول و تقبيحها، و لو نازعناهم في ذلك لم تستمر لهم شبهة و لكنا نسلم لهم جدلا يقتضيه العقل، و أن لا يكون مستدركا هذا الأصل، و نبين بطلان ما يعولون عليه مع تسليمه، فنقول:
لا يمتنع تأكيد أدلة العقول بما جاء به الرسول، و هذا بمثابة قيام أدلة عقلية على مدلول واحد، و إن كان الاكتفاء يقع بدلالة واحدة فلا نجعل ما عداها عبثا. ثم لا يمتنع أن يقع في معلوم اللّه تعالى أن الرسول إذا ابتعث كان ابتعاثه لطفا في الأحكام العقلية، و ينتدب العقلاء لها عند إرسال الرسول، فإذا لم يمتنع ما قلناه بطل ادعاؤهم بخلو الابتعاث عن غرض.
ثم نقول: لم زعمتم أن ما جاء به الرسول صلى اللّه عليه و سلّم إذا لم يكن مدلول العقل كان باطلا؟ و بم تنكرون على من يزعم أن ذلك يجري مجرى ما لو تقدم عليل إلى طبيب يسائله عما يصلح له، فهو على الجملة يعلم أن المبتغى ما يشفيه، و لكن لا يتعين له ما فيه شفاؤه، و الطبيب ينص له على ما يشفيه.
و كذلك المبعوث إليهم لا يتعين لهم قبل البعثة ما يصلحهم مما يبتعث الرسول فيه، فإذا أرسل نص على المراشد و أوضح مناهج المقاصد.
و يقال لهم: لم زعمتم أن العقول تغني عن ابتعاث الرسول صلى اللّه عليه و سلّم؟ فهلا جوزتم إرسال الرسل لتبيين الأغذية و الأدوية، و تمييزها عن السموم المؤذية و الأنبتة المضرّة، و شي ء من ذلك لا يستدرك عقلا؟ فإن قالوا: أطول التجارب يرشد إلى هذه المذاهب، قلنا: عدم التجارب إلى استقرارها يفضي إلى المعاطب و اقتحام المضار. و لو ثبت الإرشاد أولا، لما مست الحاجة إلى معاطات السموم و تمييزها عما عداها.
ص: 243
و مما تمسكوا به أن قالوا: ألفينا الشرع عندكم مشتملا على أمور مستقبحة عقلا، مع علمنا بأن الحكيم لا يأمر بالفواحش، و لا يندب إلى القبائح، قالوا: فمما تشتمل عليه الشرائع ذبح البهائم و استسخارها، و العقل قاض بقبح ذلك؛ قلنا: ما ذكرتموه ينعكس عليكم بإيلام اللّه تعالى البهائم و الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبا و لم يحتقبوا وزرا. فإن قالوا: ذلك عن اللّه حكمة، قلنا: فما كان حكمة من فعله، لم يبعد كون الأمر به أيضا حكمة، و هذا القدر مغن في غرضنا.
و ربما يشيرون إلى تخيلات لا يتشاغل بأمثالها لبيب، فيقولون: في الشرائع ما تردع منه العقول، كالانحناء في الركوع، و الانكباب على الوجه في السجود، و التحسير، و التعري، و الهرولة، و التردد بين جبلين، و رمي الجمار من غير مرميّ إليه، إلى غير ذلك مما يهزءون به.
و الوجه معارضتهم بما لا يجدون منه مخلصا، فنقول: الرب تعالى قد يضطر عبده و يفقره و يعريه، و يتركه كلحم على وضم و السوءة منه بادية، و لو عرى واحد منا عبده مع تمكنه من ستره و مواراة سوأته لكان ملوما، و الرب تعالى يفعل من ذلك ما يشاء، لا يسأل عما يفعل و هم يسألون.
و هو الذي يسلب العقول، و يضطر المجانين إلى ما يتعاطونه مما تبقى مضرته، مع القدرة على أن يكمل عقولهم. فإذا لم يبعد ما ضربنا فيه الأمثلة، أن يكون فعلا للّه تعالى، لم يبعد أيضا وقوعه مأمورا به.
فإن قالوا: إذا وقع ما ذكرتموه في أفعال اللّه تعالى، ففيه مصالح خفية هو المستأثر بعلمها، قلنا: فالتزموا مثل ذلك في الأمر بما استبعدتموه.
ص: 244
و للقوم شبه تتعلق بالمطاعن في المعجزات، و نحن نذكر عمدهم منها في تضاعيف الكلام إن شاء اللّه عز و جل.
و الدليل على جواز إرسال اللّه الرسل و شرع الملل، أن ذلك ليس من المستحيلات التي يمتنع وقوعها لأعيانها، كاجتماع الضدين، و انقلاب الأجناس و نحوها، إذ ليس في أن يأمر الرب تعالى عبدا بأن يشرع الأحكام، ما يمتنع من جهة التحسين و التقبيح.
فإذا تبين ذلك؛ قلنا: بعده مسلكان؛ أحدهما أن ننفي أصل التقبيح و التحسين عقلا، فلا يبقى بعده إلا القطع بالجواز؛ و الثاني أن نسلم التقبيح جدلا، و نقول: الإرسال ليس مما يقبح لعينه، بخلاف الظلم، و الضرر المحض، و نحوهما، و لا يتلقى قبحه بأمر يتعلق بغيره؛ فإنه لا يمتنع أن يقع في المعلوم كون الانبعاث لطفا، يؤمن عنده العقلاء و يلتزمون قضيات العقول، و لولاه لجحدوا و عندوا. فهذا قاطع في إثبات جواز النبوءات.
و من القواطع في ذلك إثبات المعجزات كما نصفها، و دلالتها على صدق المتحدي. و إذا أوضحنا كونها أدلة على صدق مدعي النبوءة، ففي ذلك أبين رد على منكري النبوءة.
اعلموا أولا أن المعجزة مأخوذة لفظا من العجز، و هي عبارة شائعة على التوسع و الاستعارة و التجوز؛ فإن المعجز على التحقيق خالق العجز، و الذين
ص: 245
يتعلق التحدي بهم لا يعجزون عن معارضة النبي صلى اللّه عليه و سلّم. فإن المعجزة إن كانت خارجة من قبيل مقدورات البشر، فلا يتصور أيضا عجز المتحدين بالمعجزات، فإن المعجز يقارن المعجوز عنه. فلو عجزوا عن معارضة، لوجدت المعارضة ضرورة، و العجز مقترن بها على ما تقصيناه في كتاب القدر. فالمعنى بالإعجاز الإنباء عن امتناع المعارضة من غير تعرض لوجود العجز الذي هو ضد القدرة.
و قد يتجوز بإطلاق العجز على انتفاء القدرة، كما يتجوز بإطلاق الجهل على انتفاء العلم. ثم في تسمية الآية معجزة تجوز آخر أيضا، و هو إسناد الإعجاز إليها، و الرب تعالى هو معجز الخلائق بها، و لكنها سميت معجزة لكونها سببا في امتناع ظهور المعارضة على الخلائق.
ثم اعلموا أن المعجزة لها أوصاف تتعين الإحاطة بها. منها أن تكون فعلا للَّه تعالى، فلا يجوز أن تكون المعجزة صفة قديمة، إذ لا اختصاص للصفة القديمة ببعض المتحدّين دون بعض. و لو كانت الصفة القديمة معجزة، لكان وجود الباري تعالى معجزا. و إنما المعجز فعل من أفعال اللّه تعالى نازل منزلة قوله لمدعي النبوءة: صدقت، على ما سنوضح وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول، و الذي ذكرنا جار فيما لا يقع مقدورا للبشر.
فإن قيل: هل يجوز أن يكون المشي على الماء، و التصعد في الهواء، و الترقي في جو السماء معجزة؟ قلنا: لا يبعد تقرير ذلك معجزة إذا تكاملت صفات المعجزات، و الحركات في الجهات من قبيل مقدورات البشر. و أما نفس الحركات، فمن اعتقد كونها من فعل اللّه تعالى، لم يبعد أن يعتقد كونها معجزة
ص: 246
من حيث كانت فعلا للَّه تعالى، لا من حيث كانت كسبا للعباد، فتكون القدرة على هذا التقدير و الحركات معجزات.
فإن قيل: لو ادعى نبي النبوءة، و قال: آيتي أن يمتنع على أهل هذا الإقليم القيام مدة ضربها، فذلك من الآيات الظاهرة، و ليست هي فعلا، بل هي انتفاء فعل؛ و قد قال شيخنا رحمه اللّه:
المعجزة فعل للَّه تعالى يقصد بمثله التصديق، أو قائم مقام الفعل يتجه فيه قصد التصديق، و أشار إلى ما ذكرناه. و الوجه عندي أن القعود المستمر مع محاولة القيام هو المعجز، فرجع المعجز إلى الفعل.
فإن قيل: إن القعود معتاد، و المعجز خارق للعادة؛ قلنا: القعود المستمر مع محاولة القيام في أقوام لا يعدون كثرة خارق للعادة؛ فهذا شريطة المعجزة.
و من شرائطها أن تكون خارقة للعادة، إذ لو كانت عامة معتادة يستوي فيها البار و الفاجر، و الصالح و الطالح، و مدعي النبوءة المحق بها و المفتري بدعواه، لما أفاد ما يقدر معجزا تمييزا و تنصيصا على الصادق، و لا خفاء بذلك فنطنب فيه.
و للبراهمة أسئلة يجب الاعتناء بها الآن. منها أن قالوا: خرق العوائد لا ينضبط، فإن ما يوجد على الندور مرة أو مرتين، لا يخرج عن قبيل الخوارق، و إذا تكرر و توالى صار معتادا، و لا ينضبط ما يلحقه بالمعتاد و يخرجه عن الخوارق، فالقول فيه مستند إلى جهالة.
و هذا لا محصول له، و هو تحويم على جحد ضرورات العقول بتخييل ليس له تحصيل؛ فإنا باضطرار نعلم أن إحياء الموتى و فلق البحر و ما شابههما ليس
ص: 247
من الأفعال المعتادة، و عدم انحصار الأعداد التي تلحقها بالمعتاد لا يدرأ هذه الضرورة، و رب شي ء لا تنضبط عدته و لا تكيف صفته، و إن كان معلوما باضطرار. و هذا بمثابة إفضاء الأخبار المتواترة إلى العلم الضروري بالمخبر عنه، فلو أردنا ضبط أقل عدد يحصل التواتر بأخبارهم لم نجد إلى ذلك سبيلا، و ليس عدد فيه أولى من عدد.
و أقصى ما نذكره أن الأعداد التي ورد الشرع بها في الشهود ليست عدد التواتر، ثم ليس لنا بعدها عدد يقطع به. و من خاطب غيره بما تحشّمه فغضب، استيقن على الضرورة غضبه. و لا يمكن ربط العلم بغضبه على احمراره أو صفة أخرى من صفاته، فإن كل صفة يشار إليها قد توجد في غير حالة الغضب.
و إن قالت البراهمة: في أصلكم أن خرق العوائد و قلبها مقدور للَّه تعالى، فليس من المستحيل أن تطرد عادة ثم يعهد مثلها، و لو اطردت لخرجت عن كونها معجزة. فإذا ادعى نبي الرسالة، و تشبث بما يخرق العادة، فما يؤمننا أن يكون ذلك أول عادة ستطرد، و لو اطردت لما كانت آية.
و القول في التّفصّي عن ذلك يطول.
و أقرب شي ء في ردهم أن نقول: لو قال نبي آيتي أن يقلب اللّه عادة معتادة و يطرد نقيضها، لكان ذلك أحق المعجزات بالدلالة على النبوءات. و لئن دل نادر واحد مع عود العادة إلى الاطراد، فلأن تدل عادة مطردة على مناقضته التي سلفت أولى. ثم إن استمر تمويههم في نادر يتحدى به نبي، فما قولهم فيه إذا بدر منه ذلك النادر، ثم انطوت أيام و دهور، و لم يعهد لذلك النادر كرور، فقد خرج عن أن يكون ابتداء عادة عوادة.
ص: 248
و من أعظم شبههم في ذلك، أن قالوا: كيف يتيقن العاقل كون ما جاء به النبي خارقا للعادة، و قد استقر في نفسه ما اطلع الحكماء عليه من خواص الأجسام و بدائع التأثيرات، حتى توصلوا إلى قلب النحاس ذهبا إبريزا، أو جر الأجسام الثقال بالأدوات الخفيفة، إلى غير ذلك من بدائع الحكم و نتائج الفكر الثاقبة؟ هذا، و مما استفاض في البرية حجر له خاصيته في جذب الحديد، فما يؤمننا أن يكون مدعي النبوة قد عثر على سرّ من هذه الأسرار و تظاهر به؟
قلنا: هذا يجر إلى إنكار البداية و التشكك في الضروريات، و كل نظر يجر إلى دفع ضرورة فهو الباطل دون الضرورة. و بيان ذلك، أنا باضطرار نعلم أنه ليس في القوى البشرية و الفكر الحكمية إحياء العظام بعد ما رمت، و إبراء الأكمه و الأبرص، و قلب العصا حية تتلقف ما يأفك السحرة؛ و من جوز التوصل إلى مثل ذلك بالحكم، و درك الخواص فقد خرج عن حيز العقلاء.
و ينبغي أن لا يبعد أن يكون في طرف من أطراف الأرض صقع تنبت فيه الحيوانات و تنمو نمو النباتات، حتى إذا التأم النبات علقت الحيوانات و جاءت بالحكم و الآيات، إلى غير ذلك من الجهالات.
ثم إذا تحدى النبي بشي ء قدرناه خارقا، فلو لم يكن خارقا لاشرأبّت النفوس لمعارضته، و انصرفت الدعاوى إلى فضحه و حطه عن دعواه. فإذا ذاعت الدعوى و شاعت آيتها و التحدي بها و تعجيز الخلائق عن الإتيان بمثلها، استبان بذلك أنه من الخوارق، و هذا القدر غرضنا في ذلك.
ص: 249
و الشريطة الثالثة للمعجزة أن تتعلق بتصديق دعوى من ظهرت على يديه؛ و هذه الشريطة تنقسم إلى أوجه لا بد من الإحاطة بها.
منها أن يتحدى النبي بالمعجزة، و تظهر على وفق دعواه، فلو ظهرت آية من شخص و هو ساكت صامت فلا تكون الآية معجزة. و إنما قلنا ذلك لأن المعجزة تدل من حيث تتنزل منزلة التصديق بالقول على ما سنذكره، و لا يتأتى ذلك دون التحدي. فإن من ادعى أنه رسول الملك، و قال بمرأى منه و مسمع: إن كنت رسولك فقم و اقعد ففعل الملك ذلك، كان ذلك بمثابة قوله:
صدقت. و لو لم يدع الرسول ذلك، بل ادعى الرسالة مطلقا، و قام الملك و قعد لما كان ذلك دالا على تصديقه فلا بد من التحدي إذا.
ثم يكفي في التحدي أن يقول: آية صدقي أن يحيي اللّه هذا الميت، و ليس من شرط المتحدي أن يقول: هذه آيتي و لا يأتي أحد بمثلها؛ فإن الغرض من التحدي ربط الدعوى بالمعجزة، و ذلك يحصل دون أن يقول: و لا يأتي أحد بمثلها؛ فهذا وجه من وجوه تعلق المعجزة بالدعوى.
و من وجوهه أن لا تتقدم المعجزة على الدعوى، فلو ظهرت آية أو لا و انقضت، فقال قائل:
أنا نبي و الذي مضى كانت معجزتي، فلا يكترث به، إذ لا تعلق لما انقضى بدعواه. فإن قيل: إذا نظرنا إلى صندوق و ألفيناه خلوا، و أقفلناه و تركناه بمرأى منا؛ فقال مدعي النبوءة: آية نبوءتي أنكم تصادفون في هذا الصندوق ثيابا، فإذا فتحنا الصندوق و ألفينا المتاع كما وصف كان ذلك آية. قلنا:
نحن و إن كنا نجوز تقدم اختراع ذلك المتاع على دعواه، و لكن قوله المبني على الغيب آية، و ذلك مطابق لدعواه، فاعلموا.
ص: 250
فإن قيل: هل يجوز استيخار المعجزة عن دعوى النبوءة؟ قلنا: إن تأخرت و طابقت الدعوى كانت آية. ذلك مثل أن يقول النبي: آية صدقي انخراق العادة بكذا و كذا وقت الصبح؛ فإذا وقع ذلك كما وعد، و كان خارقا للعادة كان آية.
فإن قيل: لو قال مدعي النبوءة ستظهر آيتي بعد موتي بوقت ضربه، فإذا وقع ما قاله بعد الوفاة على حسب دعواه، كان ذلك خارقا للعادة؛ فالوجه عندي في ذلك أن نقول: إن كلف الناس التزام الشرع ناجزا، و الآية موقوفة، فقد كلفهم شططا؛ و إن نص على الأحكام و على التزامها بوقت ظهور الآية صح ذلك و القاضي أبو بكر رضي اللّه عنه منع ما صححته، و لا وجه لمنعه، و الحق أحق أن يتبع.
و من وجوه تعلق المعجزة بالتصديق، أن لا تظهر مكذبة للنبي، مثل أن يدعي مدعي النبوءة، فيقول: آية صدقي أن ينطق اللّه يدي، فإذا أنطقها اللّه تعالى بتكذيبه و قالت: اعلموا أن هذا مفتر فاحذوره، فلا يكون ذلك آية. و لو قال: آيتي أن يحيي اللّه هذا الميت، فأحياه اللّه تعالى فقام و له لسان زلق، فقال: صاحبكم هذا متخرص، و قد بعثني اللّه تعالى لأفضحه ثم خر صعقا، فقد قال القاضي رضي اللّه عنه: هذه آية مكذبة لا تدل.
و الذي عندي في ذلك أن التكذيب إن كان خارقا للعادة فهو الذي يقدح في المعجزة، و ذلك بمثابة نطق اليد بالتكذيب. فأما الميت إذا حيي و كذب فتكذيبه ليس بخارق للعادة. و للنبي أن يقول: إنما الآية إحياؤه و تكذيبه إياي كتكذيب سائر الكفرة.
ص: 251
فالذي صار إليه أهل الحق جواز انخراق العادات في حق الأولياء، و أطبقت المعتزلة على منع ذلك، و الأستاذ أبو إسحاق رضي اللّه عنه يميل إلى قريب من مذاهبهم.
ثم مجوزو الكرامات تحزبوا أحزابا. فمن صائر إلى أن شرط الكرامة الخارقة للعادة أن تجري من غير إيثار و اختيار من الولي، و صار هؤلاء إلى أن الكرامة تفارق المعجزة من هذا الوجه، و هذا غير صحيح لما سنذكره. و صار صائرون إلى تجويز وقوع الكرامة على حكم الاختيار، و لكنهم منعوا وقوعها على قضية الدعوى؛ فقالوا: لو ادعى الولي الولاية، و اعتضد إيثار دعوته بما يخرق العادة، فإن ذلك ممتنع، و هؤلاء يقدرون ذلك تمييزا بين الكرامة و المعجزة. و هذه الطريقة غير مرضية أيضا، و لا يمتنع عندنا ظهور خوارق العوائد مع الدعوى المفروضة.
و صار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة لنبي، لا يجوز وقوعه كرامة لولي؛ فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر، و تنقلب العصا ثعبانا، و يحيي الموتى كرامة لولي، إلى غير ذلك من آيات الأنبياء؛ و هذه الطريق غير سديدة أيضا. و المرضي عندنا، تجويز جملة خوارق العوائد في معارض الكرامات.
و غرضنا من تزييف هذه الطرق و إثبات الصحيح عندنا، و الميز بين الكرامة و المعجزة، يستبين بذكرنا عمد نفاة الكرامة؛ و تفصّينا عنها، و تعويلنا على القواطع في إثباتها.
ص: 252
فمما تمسك به نفاة الكرامة أن قالوا: لو جاز انخراق العادة من وجه، لجاز ذلك من كل وجه،
ثم يجر مقاد ذلك إلى ظهور ما كان معجزة لنبي على يد ولي، و ذلك يفضي إلى تكذيب النبي المتحدي بآيته، القائل لمن تحداه: لا يأتي أحد بمثل ما أتيت به. فلو جاز إتيان الولي بمثله، لتضمن ذلك نسبة الأنبياء إلى الافتراء.
و هذا تمويه لا تحصيل له، إذ لا خلاف في أن الشي ء الواحد من خوارق العوائد يجوز أن يكون معجزة لنبي بعد نبي، ثم لا يكون ظهوره ثانيا مكذّبا لمن تحدى به أولا. فإن قالوا: النبي يقيّد دعواه في خطاب من تحداه، و يقول: لا يأتي أحد بمثل ذلك إلا من يدعي النبوة صادقا في دعواه.
قلنا إن ساغ تقييد الدعوى بما ذكرتموه، فلا يمتنع أيضا أن يقول النبي لا يأتي بمثل ذلك متنبي و لا ممخرق مفتر، و لا من يروم تكذيبي؛ و تخرج الكرامات عن هذه الجهات و ليس تقييد أولى من تقييد.
و مما احتجوا به، أن قالوا: لو جوزنا انخراق العوائد للأولياء، لم نأمن في وقتنا وقوعه، و ذلك يؤدي إلى أن يتشكك اللبيب في جريان دجلة دما عبيطا، و انقلاب الأطواد ذهبا إبريزا، و حدوث بشر من غير إعلاق و ولادة، و تجويز ذلك سفسطة و تشكك في الضروريات.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه ينعكس عليكم في زمان الأنبياء؛ فإن الذين كانوا في مدة الفترة، و هي ما بين العروج بعيسى عليه السلام إلى ابتعاث محمد صلى اللّه عليه و سلّم، كان لا يسوغ منهم تجويز ما منعتم تجويزه في محاولة دفع
ص: 253
الكرامات. و لما ابتعث النبي، و ظهرت الآيات، و انخرقت العادات، استلّ عن صدور العقلاء الأمن من وقوع خوارق العوائد.
و هذا سبيلنا في الذي دفعنا إليه، فنحن الآن على أمن من أن ما قدروه لا يقع. فإن قدر اللّه وقوعه قلب العادة، و أزال العلوم الضرورية بأن ما قدروه لا يقع. فقد بطل ما قالوه، و استبان بانفصالنا عنه أصل في الكرامة.
فإن قيل: ما دليلكم على تجويزها؟ قلنا: ما من أمر يخرق العوائد إلا و هو مقدور للرب تعالى ابتداء، و لا يمتنع وقوع شي ء لتقبيح عقل لما مهدناه فيما سبق. و ليس في وقوع الكرامة ما يقدح في المعجزة؛ فإن المعجزة لا تدل لعينها، و إنما تدل لتعلقها بدعوى النبي الرسالة و نزولها منزلة التصديقي بالقول. و الملك الذي يصدق مدعي الرسالة بما يوافقه و بما يطابق دعواه، لا يمتنع أن يصدر منه مثله إكراما لبعض أوليائه. و لا يقدح مرام الإكرام في قصد التصديق، إذا أراد التصديق، و لا خفاء بذلك على من تأمل.
فإن قيل: فما الفرق بين الكرامة و المعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في جواز العقل، إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوءة.
و استدل مثبتو الكرامات بما لا سبيل إلى درئه في مواقع السمع. فإن أصحاب الكهف و ما جرى لهم من الآيات لا سبيل إلى جحده، و ما كانوا أنبياء إجماعا. و كذلك خصت مريم عليها السلام بضروب من الآيات؛ فكان زكريا صلوات اللّه عليه يصادف عندها فاكهة الشتاء في الصيف و فاكهة الصيف في الشتاء، و يقول معجبا: «أَنَّى لَكِ هذا»[ال عمران : 37]. و تساقط عليها
ص: 254
الرطب الجنيّ، إلى غير ذلك من آياتها. و كذلك أم موسى عليها السلام، ألهمت في أمره بما لا خفاء به. و جرى من الآيات في مولد الرسول عليه السلام ما لا ينكره منتم إلى الإسلام، و كان ذلك قبل النبوءة، و الانبعاث و المعجزة لا تسبق دعوى النبوءة كما قدمناه.
فإن تعسف بعضهم و زعم أن الآيات التي استدللنا بها كانت معجزات لنبي كل عصر، فذلك اقتحام للجهالة. فإنا إذا بحثنا عن العصور الخالية، لم نلف الآيات التي تمسكنا بها مقترنة بدعوى، بل كانت تقع من غير تحد لمتحد. فإن قالوا: إنما وقعت للأنبياء دون دعواهم فشرط المعجزة الدعوى، فإذا فقدت كانت خوارق العادات كرامة للأنبياء، و يحصل بذلك غرضنا في إثبات الكرامات و لم يكن في وقت مولد الرسول نبي تستند إليه آياته. فقد وضحت الكرامات جوازا و وقوعا، عقلا و سمعا.
هذا الفصل في إثبات السحر و تمييزه عن المعجزة و نذكر فيه إثبات الجن و الشياطين و الرد على منكريهم.
فأما السحر فثابت، و نحن نصفه أولا، ثم ندل عقلا على جوازه و نتمسك بموارد السمع على وقوعه و نذكر تمييزه عن المعجزة في خلال الكلام. فلا يمتنع أن يترقى الساحر في الهواء، و يتحلق في جو السماء و يسترق و يتولج في الكواء و الخوخات، إلى غير ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر، إذ الحركات في الجهات من قبيل مقدورات الخلق. و لا يمتنع عقلا أن يفعل الرب تعالى عند
ص: 255
ارتياد الساحر ما يستأثر بالاقتدار عليه، فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة اللّه تعالى عندنا.
و الدليل على جواز ذلك، كالدليل على الكرامة. و وجه الميز هاهنا بين السحر و المعجزة كوجه الميز في الكرامة، فلا وجه إلى إعادته. و قد شهدت شواهد سمعية على ثبوت السحر؛ منها قصة هاروت و ماروت، و منها سورة الفلق مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن أعصم اليهودي لرسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم، فإنه سحره على مشط و مشاطة تحت راعوفة في بئر ذروان.
و سحر ابن عمر فتوعكت يده، و سحرت جارية عائشة رضي اللّه عنها.
و اتفق الفقهاء على وجود السحر و اختلفوا في حكمه، و هم أهل الحل و العقد، و بهم ينعقد الإجماع، و لا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة فقد ثبت السحر جوازا و وقوعا.
ثم اعلموا أن السحر لا يظهر إلا على فاسق، و الكرامة لا تظهر على فاسق، و ليس ذلك من مقتضى العقل، و لكنه متلقى من إجماع الأمة. ثم الكرامة و إن كانت لا تظهر على معلن بفسقه، فلا تشهد بالولاية على قطع، إذ لو شهدت بها لأمن صاحبها العواقب، و ذلك لم يجر لولي في كرامة اتفاقا.
فإن قيل: بيّنوا مذهبكم في الجن و الشياطين، قلنا: نحن قائلون بثبوتهم، و قد أنكرهم معظم المعتزلة، و دل إنكارهم إياهم على قلة مبالاتهم، و ركاكة ديانتهم، فليس في إثباتهم مستحيل عقلي.
و قد نصت نصوص الكتاب و السنة على
ص: 256
إثباتهم. و حق اللبيب و المعتصم بحبل الدين، أن يثبت ما قضى العقل بجوازه، و نص الشرع على ثبوته. و لا يبقى لمن ينكر إبليس و جنوده، و الشياطين المسخرين في زمن سليمان، كما أنبأ عنهم آي من كتاب اللّه تعالى لا يحصيها، مسكة في الدين، و علقة يتشبث بها، و اللّه الموفق للصواب، و هذا غرضنا من هذا الباب.
ص: 257
اعلموا، أرشدكم اللّه تعالى، أن المعجزة لا تدل على صدق النبي، حسب دلالة الأدلة العقلية على مدلولاتها. فإن الدليل العقلي يتعلق بمدلوله بعينه، و لا يقدر في العقل وقوعه غير دال عليه، و ليس ذلك سبيل المعجزات.
و بيان ذلك بالمثال في الوجهين أن الحدوث لما دل على المحدث، لم يتصور وقوعه غير دال عليه، و انقلاب العصا حية، لو وقع بديّا من فعل اللّه عز و جل من غير دعوى نبي، لما كان دالا على صدق مدع فقد خرجت المعجزات عن مضاهات دلالات العقول.
فإن قيل: فما وجه دلالتها إذا؟ قلنا: هذا مما كثر فيه خبط من لا يحسن علم هذا الباب.
و المرضي عندنا أن المعجزة تدل على الصدق من حيث تتنزل منزلة التصديق بالقول، و غرضنا يتبين بفرض مثال، فنقول:
إذا تصدر ملك للناس، و تصدر لتلج عليه رعيته، و احتفل الناس و احتشدوا، و قد أرهق الناس شغل شاغل.
فلما أخذ كلّ مجلسه، و ترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد من خواص الملك، و قال:
معاشر الأشهاد! قد حل بكم أمر عظيم، و أظلكم خطب جسيم، و أنا رسول الملك إليكم، و مؤتمنه لديكم، و رقيبه عليكم، و دعواي هذه بمرأى من الملك و مسمع. فإن كنت أيها الملك صادقا في دعواي، فخالف عادتك
ص: 258
و جانب سجيتك، و انتصب في صدرك و بهواك، ثم اقعد، ففعل الملك ذلك على وفق ما ادعاه و مطابقة هواه، فيستيقن الحاضرون على الضرورة تصديق الملك إياه و ينزل الفعل الصادر منه منزلة القول المصرح بالتصديق.
فهذه العمدة في ضرب المثال، و ها نحن نبني عليه أسئلة و نتفصى منها، و يندرج تحت ما نطرده أغراض يعظم خطرها.
فمن أهم الأسولة ما أدلى به المعتزلة، حيث قالوا: إذا جوزتم أن يضل الرب عباده، و يغويهم و يرديهم، فما يؤمنكم من إظهار المعجزات على أيدي الكذابين لإضلال الخلائق؟ و قال: أصلنا في تنزيه الرب تعالى عن فعل الجور و إضلال العباد، يؤمننا مما ألزمناكموه و تدل المعجزة على الصدق، من حيث نعلم أن الرب تعالى يخصصها بالصادقين. و لا يثبتها للكاذب فيضل الخلق.
و الجواب عن ذلك، أن نقول: من شهد مجلس الملك في الصورة المفروضة، علم على الضرورة تصديق الملك من يدعي الرسالة، و إن لم يخطر لمعظم الحاضرين نظر و عبر و تفكر في أن الملك لا يغوي رعيته، و لا يطغى حاشيته، و لو كانت دلالة المعجزة على الصدق موقوفة على العلم بأن مظهر المعجزة لا يطغى و لا يضل، لاختص بالعلم برسالة الملك من نظر هذا النظر، و استدت منه العبر، و ليس الأمر كذلك على اضطرار؛ و الذي يكشف الحق في ذلك، أن الملك لو كان ظالما غاشما لا تؤمن بوادره، فالفعل المفروض ممن هذه صفته تصديق لمدعي الرسالة، و جاحد ذلك منكر للبديهة.
ص: 259
ثم نقول للمعتزلة: ما وجه دلالة المعجزة عندكم؟ فإن قالوا: وجهها علمنا بأن اللّه تعالى لا يضل خلقه، قلنا: فعلمكم على زعمكم يقارن المعتاد من الأفعال، حسب مقارنته للخارق منها للعادة، فجوزوا أن يقع فعل معتاد مع اعتقادكم علما للنبي، فإن قالوا: لا بد من اختصاص المعجزة بوجه لأجله تدل، قلنا: فبينوه نتكلم عليه، فلا يزالون في عمه و حيرة، أو يرجعوا إلى الحق. فإذا أوضحوا وجها، سوى ما انتحلوه من فاسد معتقدهم، فنقول: لا تظهر المعجزة على يدي الكاذب، لأنها لو ظهرت لدلت على صدقه، و تصديق الكاذب مستحيل في قضيات العقول.
فإن قيل: هل تجوزون في المقدور وقوع المعجزة على حسب دعوى الكاذب، أم تقولون ليس ذلك من المقدور؟ قلنا: ما نرتضيه في ذلك أن المعجزة يستحيل وقوعها على حسب دعوى الكاذب، لأنها تتضمن تصديقا و المستحيل خارج عن قبيل المقدورات، و وجوب اختصاص المعجزة بدعوى الصادق، كوجوب اقتران الألم بالعلم به في بعض الأحوال، و جنس المعجزة يقع من غير دعوى، و إنما الممتنع وقوعه على حسب دعوى الكاذب، فاعلموا ذلك.
فإن قيل: إن ثبت لكم ما ادعيتموه في المثال الذي فرضتموه، فبم تردون الغائب إلى الشاهد، مع علمكم بأنه لا بد من جامع بينهما، فإن روم الجمع من غير جامع يجر إلى الدهر و الإلحاد؟
و ربما عضدوا هذا السؤال بآخر، فقالوا: إنما علمنا رسالة مدعيها بقرائن الأحوال، و ما أحسسنا منها، و ذلك مفقود غير موجود في حكم الإله.
ص: 260
و هذا آخر عقدة في النبوءات، فإذا انحلت لم يبق بعدها للطاعنين مضطرب؛ فنقول مستعينين باللَّه تعالى: ما ذكرناه شاهدا بمثابة التقريب، و ضرب الأمثلة للإيضاح، و لم نذكره مستدلين به فإن سبيل ما ذكرناه من قبيل الضروريات، و لا يستدل عليها، و لكن قد تضرب فيها الأمثال.
و ها نحن نوضح مثل ما ذكرناه شاهدا و غائبا، فنقول: المعجزة إنما تدل في حق من يعتقد الرب قادرا يفعل ما يشاء، فيقول النبي في مخاطبة من سبق اعتقاده للإلهية: قد علمتم أن ابتعاث النبي غير منكر عقلا، و أنا رسول اللّه إليكم، و آية صدقي أنكم تعلمون تفرد الرب تعالى بالقدرة على إحياء الموتى، و تعلمون أن اللّه عالم بسرنا و علانيتنا و ما نخفيه من سرائرنا و نبديه من ظواهرنا، و إنما أنا رسول اللّه إليكم، فإن كنت صادقا، فاقلب يا رب هذه الخشبة حية تسعى؛ فإذا انقلبت كما قال، و أهل الجمع عالمون باللَّه تعالى فحينئذ يعلمون على الضرورة أن الرب تعالى قصد بإبداع ما أبدع تصديقه، كما ذكرناه شاهدا.
و ما موّهوا به من قرائن الأحوال، لا محصول له. فإن من كان غائبا عن المجلس الموصوف، فبلغه ما جرى، شارك الحاضرين في العلم بالرسالة و إن لم يحس حالا، و كذلك لو كان الملك في بيت مستخل بنفسه، و دونه السجف المسدولة، فقال مدعي الرسالة: إن كنت رسولك فحرك الحجب، و أشل السجوف، ففعل ذلك كان تصديقا، و إن لم ير الملك، فلما جرى التصديق من وراء الحجاب، انقطعت هذه الأسباب، و انحسمت الأبواب، و وضح الحق، و اللّه المشكور على كل حال.
ص: 261
و يعتضد ما ذكرناه، بأن أهل المراء و الشكوك تحزبوا في زمان الأنبياء؛ فمنهم من أنكر الإلهية، و خامرته الشكوك في النبوءات لذلك؛ و منهم من اعتقد كون النبي ساحرا، و صار إلى أن الصادر منه تخييل، و ما اعتقد معتقد في دهر من الدهور كون المعجزة فعلا للَّه تعالى على الابتداء، موافقا لدعوى النبي، ثم استراب في النبوءات و ذلك شاهد على أن ذلك موقع ضرورة، لا مجال للشكوك فيه.
فهذا قولنا في دلالة المعجزة على صدق الرسول، و لا يكاد يستتب ذلك للمعتزلة. فإن معنى ما ذكرناه على القصد إلى التصديق، و يعسر على المعتزلة إثبات قصد اللّه تعالى؛ فإنهم نفوا إرادة قديمة و منعوا كونه مريدا لنفسه. و وضح بما قدمناه، بطلان كونه مريدا بإرادة حادثة، فلا يبقى لهم متعلق في إثبات قصد إلى تصديق.
فإن قيل: هل في المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة؟ قلنا: ذلك غير ممكن، فإن ما يقدر دليلا على الصدق لا يخلو: إما أن يكون معتادا، و إما أن يكون خارقا للعادة. فإن كان معتادا، يستوي فيه البر و الفاجر، فيستحيل كونه دليلا. و إن كان خارقا للعادة، يستحيل كونه دليلا دون أن يتعلق به دعوى النبي، إذ كل خارق للعادة يجوز تقدير وجوده ابتداء من فعل اللّه تعالى؛ فإذا لم يكن بد من تعلقه بالدعوى، فهو المعجزة بعينها.
ص: 262
فإن قيل: إن سلم لكم ما ذكرتموه من نزول المعجزة منزلة التصديق بالقول، فلا يتم غرضكم دون أن تثبتوا استحالة الخلف و امتناع الكذب في حكم اللّه سبحانه، و لا سبيل إلى إثبات ذلك بالسمع، فإن مرجع الأدلة السمعية إلى قول اللّه تعالى؛ فما لم يثبت وجوب كونه حقا صدقا، لا يستمر في السمع أصلا. و لا يمكن أن يحتج في ذلك بالإجماع؛ فإن العقل لا يدل على تصحيح الإجماع، و إنما يتلقى صحته من كتاب اللّه تعالى.
و لا يمكن التمسك في تنزيه الرب تعالى عن الكذب بكونه نقصا من وجهين: أحدهما أن الكذب عندكم تحكم لا يقبح لعينه؛ و الثاني أنه لو سلم أنه نقص، فالمعتمد في نفي النقائص دلالة السمع. قلنا: أما الرسالة فإنها تثبت دون ذلك في الحال، و لا يتعلق إثباتها بأخبار تتصدى لكونها صدقا أو كذبا. كأن المرسل قال: جعلته رسولا، و أنشأت ذلك فيه آنفا، و لم يقل ذلك مخبرا عما مضى.
و سبيل ذلك كسبيل قول القائل: و كلتك في أمري و استنبتك لشأني، فهذا توكيل ناجز يستوي فيه الصادق و الكاذب. و محصول القول فيه أن صيغة التوكيل، و إن كانت أخبارا، فالغرض منها أمر بانتداب لشأن و انتصاب لشغل، و الأمر لا يدخله الصدق و الكذب. و آية ذلك أن الملك و إن نقم عليه كذب و خلف، فالفعل الذي فرضناه منه يصدق الرسول و يثبت الرسالة، قطعا على
ص: 263
الغيب من غير ريب. فهذا موقف لا يتوقف ثبوته على نفي الكذب عن الباري سبحانه و تعالى، فاعلموه.
و لكن لا يثبت صدق النبي، بعد ثبوت الرسالة، فيما يؤديه و ينهيه، و يشرعه من الأحكام و يشرحه من الحلال و الحرام، إلا مع القطع بتقدس الباري تعالى عن الخلف و الكذب. فإن النبي يعتضد فيما يدعيه من صدق نفسه في تبليغه، بتصديق اللّه إياه. و ما لم يثبت وجوب كون تصديقه تعالى حقا صدقا، لا يثبت صدق النبي في أنبائه. و ليس تصديقه فيما يبلغه تفصيلا، بمثابة انتصابه رسولا؛ فإن حقيقة نصبه يرجع إلى إثبات أمر، و الإخبار عن صدقه فيما يخبر به يتعرض لكونه صدقا أو كذبا.
و قد عول الأستاذ أبو إسحاق رضي اللّه عنه، في كتابه المترجم بالجامع، على فصل و حث على التمسك به، فقال: الأحكام لا ترجع عندنا إلى صفات الأفعال، و إنما ترجع إلى تعلق الكلام القديم بها. و الشي ء لا يجب لنفسه، و لكن يقضي فيه بالوجوب، للتوعد على تركه و وعد الثواب على فعله. و الوعد و الوعيد خبران، فلو لم يثبتا على حكم الصدق، لم يوثق بهما. و إذا كان كذلك، لم يتقرر إيجاب و حظر، و ندب إلى الطاعة و تحذير من المخالفة. و يؤول قصارى ذلك إلى أن لا يتصور للباري تعالى أمر مطاع، و قد دلت الأدلة على كونه إلها قادرا عالما، و لا تعقل الإلهية ممن لا يتصور منه الأمر و النهي و قال عند اختتام هذا الفصل و لو لم يتفق في كتابنا إلا هذا لكان بالحري أن يغتبط به.
ص: 264
و قد أبنا ما فهمناه من كلام ذلك الحبر رضي اللّه عنه، و لسنا نرى ذلك مقنعا في الحجاج، و لا سبيل إلى حسم الطلبات عما ذكرناه، و لا وجه لادعاء الضرورة. و الذي عليه التعويل في غرض الفصل، أنا نقول: قد أوضحنا الطرق الموصلة إلى كون الباري سبحانه عالما مريدا، و قد قدمنا ما فيه مقنع في إثبات كلام النفس. و العالم بالشي ء المريد له، لا يمتنع أن يقوم به أخبار من المعلوم المراد، على حسب تعلق العلم و الإرادة به.
و كل معنى يقبله الموجود، فإنه لا يعرى عنه أو عن ضده، إن كان له ضد، كما قرر في صدر الاعتقاد. فلو لم يتصف الباري تعالى بخبر صدق، لوجب اتصافه بضده؛ و إذا اتصف بضده استحال أن يقدر ذلك الصدق ذهولا و غفلة عما قدرناه مخبرا عنه. فإن الذهول كما يضاد الخبر عن الشي ء، فإنه يضاد أيضا العلم به و إرادته. و إن كان ضد الخبر الصدق، خبرا هو خلف و كذب واقع على خلاف المخبر، فيجب مع تقدير ذلك الوصف بقدمه و القضاء باستحالة عدمه، لما قدمناه من إثبات قدم الكلام.
ثم يئول منتهى ذلك إلى أنه يستحيل من الباري تعالى أن يخبر عما علمه، على حسب تعلق العلم به. و ذلك معلوم بطلانه؛ فإنا نعلم قطعا أن العالم بالشي ء يستحيل أن يتصف، على علمه به بصفة يستحيل عليه معها كلام نفسه، المتعلق بمعلومه على حسب تعلق العلم به، حتى يقال مستحيل مع العلم به إخبار
ص: 265
النفس عنه. فإذا امتنع ادعاء هذه الاستحالة شاهدا، و انتسب جاحد ما قلناه إلى دفع البديهة، فيلزم طرده شاهدا و غائبا.
فإن قيل: كيف ادعيتم البديهة في فرع أصله متنازع فيه، فإن معظم المتكلمين صاروا إلى إنكار كلام النفس؟ قلنا: الذي يدعي أهل الحق أن كلام النفس لا ينكر، و إنما التنازع في أن ما ادعيناه: هل هو كلام، أو هو اعتقاد، أو علم. فأما هواجس النفس و خواطرها، فالاتصاف بها معلوم لا يجحد.
فإن قالوا: ليس يمتنع مع تقدير كلام النفس، أن يعلم العالم كون زيد في الدار، و يدير في خلد نفسه مع ذلك أنه ليس في الدار، قلنا: هذا تخييل و وهم، فإن ذلك الكلام الدائر أخبار، و ليس بخبر ناجز مثبت. و الذي يحقق ذلك، أن العالم بالشي ء مع الإخبار عنه على حسب العلم به بتا قطعا، يدير في نفسه ما صوره السائل. و حديث النفس على حكم الصدق مستدام، كما كان قبل خطور هذا التقدير.
و لو كان ما ألزمه السائل ثابتا، لاستحال اجتماعه مع نقيضه. و كل عالم بالشي ء مخبر عنه على حقيقته، يجد من نفسه على الضرورة الاتصاف بكونه مخبرا عنه، مع تقديره مخبرا، على حكم الخلف. و سبيل ذلك كسبيل العلم بالشي ء على ما هو به، مع تقدير اعتقاده فيه على خلاف ما هو به، فلا يكون الاعتقاد المقدر مع العلم المتقرر اعتقادا محققا.
فاستبان بما ذكرناه، أن المصير إلى تقدير صفة يستحيل معها الاتصاف بحديث النفس عن المعلوم بالعلم، على حسب تعلق العلم به ادعاء استحالة
ص: 266
تأباها العقول. و يعتضد ما ذكرناه بأن العالم بالشي ء، لو لم يتكلف إخطار خلف بقلبه، لاستمر له حديث النفس صدقا مع العلم بالذي يتكلف تقديرا، و ليس بصفة مضادة للحديث الصادق.
فهذا القدر كاف هنا، و هو قاض باتصاف الباري تعالى بالكلام المتعلق بالمعلوم، على حسب تعلق العلم به. و من ابتغى مزيدا على ذلك، فليتأمل الشامل.
ص: 267
قد قدمنا ما يتعلق بإثبات أصل النبوءات على الجملة، و غرضنا الآن الاعتناء بإثبات نبوءة نبينا محمد صلى اللّه عليه و سلّم.
و قد أنكر نبوءته طائفتان، تمسكت إحداهما بالمصير إلى منع النسخ، و تمسكت الأخرى بالمماراة في آياته و معجزاته. و ذهبت طائفة من اليهود يسمون العيسوية «1»، إلى إثبات نبوءة محمد صلى اللّه عليه و سلّم، و لكنهم خصصوا شرعه بالعرب دون من عداهم.
فأما من أنكر النسخ، و إليه ذهب معظم اليهود، فمقصدنا في إبطال ما انتحلوه لا يتبين إلا بذكر حقيقة النسخ على اختصار و اقتصار على ما فيه غنية.
فالمرضي عندنا، أن النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب أخر، على وجه لولاه لاستمر الحكم المنسوخ. و من ضرورة ثبوت النسخ على التحقيق، رفع حكم بعد ثبوته.
و المعتزلة يصيرون إلى أن النسخ لا يرفع حكما ثابتا، و إنما يبين انتهاء مدة شريعة، و إلى ذلك مال بعض أئمتنا، و قالوا: النسخ تخصيص الزمان؛ و عنوا به أن المكلفين إذا خوطبوا بشرع مطلق، فظاهر مخاطبتهم به تأبيده عليهم، فإذا نسخ استبان أنه لم يرد باللفظ إلا الأوقات الماضية.
ص: 268
و هذا عندنا نفي للنسخ و إنكار لأصله، ورد له إلى تبيين معنى لفظ لم يحط به أولا و تنزيل له منزلة تخصيص صيغة عامة، و المخصص من الصيغة العامة غير مراد بها، و نحن نلزم المعتزلة و من انتمى إلينا فصلين على موجب أصلين.
فنقول للمعتزلة: من أصلكم أن تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة غير سائغ، فلو كان النسخ تبيينا له، لما استأخر عن اللفظ الوارد أولا، كما لا يستأخر التخصيص عندهم عن اللفظة العامة لو جردت عن مخصصها، و لا محيص لهم عن ذلك.
و نقول للمنتمين إلينا: قد علمتم مصيرنا إلى جواز نسخ العبادة المفروضة قبل مضي وقت يسعها، و يستحيل مع المصير إلى ذلك القول بأن النسخ تبيين لانقطاع وقت العبادة، إذ يستحيل أن يقدر للعبادة وقت لا يسعها. ثم إبراهيم صلى اللّه عليه و سلّم، مأمور عندنا و عند أصحابنا بالذبح أولا، و نسخ ذلك عنه آخرا، و عين المأمور به هو الذبح، و لم يكن أفعالا تمتد و تتعدد، حتى يصرف الأمر إلى الشي ء، و النسخ إلى غيره.
و إذا صرف النسخ إلى عين المأمور به، كان رفعا للحكم على التحقيق؛ فإذا استبان ذلك رددنا على اليهود المنكرين للنسخ، و قلنا: ليس بين الجواز و الاستحالة رتبة معقولة، و وجوه الاستحالة مضبوطة فرب شي ء يستحيل لنفسه، كانقلاب الأجناس، و اجتماع الضدين، و الأمر بما نهى عنه ليس مما يستحيل لنفسه، فإن تصويره ممكن، لا استحالة فيه؛ فإذا لم يستحل لنفسه، امتنع صرف استحالته إلى غيره، إذ ليس في تجويزه خروج صفة من صفات الإلهية عن حقيقتها؛ فإن الحكم ليس بصفة للفعل نفسية كما قدرناه، و ليس في
ص: 269
تقدير النسخ ما يفضي إلى تغير العلم و الإرادة، و لا يزال السبر يطرد حتى يستبين أن النسخ لا يستحيل لنفسه، و لا يفضي إلى استحالة في غيره.
فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أنه يستحيل لإفضائه إلى اتصاف الباري تعالى بالبداء، و هو متقدس عنه؟ قلنا: البداء يعبر عن استفادة علم ما لم يكن، و من أحاط بما لم يكن محيطا به، يقال بداله، و قد يعبر به عن من يهم بأمر ثم يندم على ما هم، و لا يتقرر شي ء من ذلك في النسخ؛ فإن علم الباري سبحانه متعلق بالمعلومات على ما هي عليه، و لا يتجدد له علم لم يكن، و الإرادة على أصولنا لا يعتبر بها الأمر؛ فإن الرب سبحانه و تعالى يأمر بما لا يريده، و يريد ما لا يأمر به، فلم يبق لادعاء البداء وجه.
و قد تمسك نفاة النسخ بتخيل لا يقوم بالانفصال عنه إلا متبحر في هذا الشأن، و ذلك أنهم قالوا: ما أوجبه اللّه تعالى فقد أخبر عن كونه واجبا؛ فلو حظره و أخبر عن كونه محظورا، لا نقلب الخبر الأول خلقا واقعا على خلاف مخبره، و ذلك مستحيل.
و الذي ذكروه تخييل ليس له تحصيل و ذلك أن الوجوب ليس بصفة للواجب على أصلنا؛ و المعنى بكون الشي ء واجبا أنه الذي قيل فيه «افعل»: فإذا أخبر الرب تعالى عن وجوب الشي ء فمعناه أنه أخبر عن الأمر به؛ فإذا نهى عنه أخبر عن النهي عنه؛ فليس بين الإخبار عن الأمر به تحقيقا و بين الإخبار عن النهي عنه تناقض، فلا يتصف كل واحد من الخبرين بالخروج عن كونه صدقا حقا.
ص: 270
و إنما تخيل هؤلاء ما قالوه، من حيث اعتقدوا الوجوب صفة للواجب، و قدروها مخبرا عنها، ثم قدروا الخبر عن نفسها. و صعب موقع ذلك عندهم من حيث علموا أن النسخ رفع حكم ثابت، و ليس بآئل إلى تبيين ما لم يثبت. و من أحاط بما ذكرناه، هان عليه مدرك الانفصال عن السؤال. و إذا ثبت جواز النسخ عقلا، فليس تمنع منه دلالة سمعية.
و قد نبغت شرذمة من اليهود و تلقنوا من ابن الراوندي (1) سؤالا و استذلوا به الطغام و العوام من أتباعهم، و قالوا: النسخ جائز عند الإسلاميين، و لكنهم قالوا بتأبيد شريعتهم إلى تصرم عمر الدنيا، فإذا سئلوا الدليل على ذلك، رجعوا إلى إخبار نبيهم إياهم بتأبيد شريعته، و نحن نقول قد أخبرنا موسى بتأبيد شريعته، فلتتأبد، و هو المصدق إجماعا، و هذا الذي ذكروه باطل من وجهين.
أحدهما ما نقلوه لو صح لكان صدقا، و لو ثبت صدقا حقا، لما ظهرت المعجزات على يدي عيسى و محمد عليهما السلام، فلما ظهرت دلت على كذب اليهود. و مهما ظهرت معجزة في شرعنا على يد متنبي تنبأ، تبين إذ ذاك كذبنا في تأبيد شريعتنا، فهذا وجه ظاهر. فإن عادوا إلى القدح في معجزة عيسى و محمد عليهما السلام، لم يبدوا وجها في مرامهم، إلا انقلب عليهم مثله في معجزة موسى، عليه السلام.
ص: 271
و الوجه الثاني أن نقول لو صح ما قلتموه و لقنتموه، لكان أولى الأعصار بإظهار ذلك عصر النبي صلى اللّه عليه و سلّم، و معلوم أن الجاحدين منكم لنبوءة محمد صلى اللّه عليه و سلّم لم يألوا جهدا في رد النبوءة، و غيروا نعت محمد صلّى اللّه عليه و سلّم في التوراة، فلو كان فيها نص لا يقبل التأويل، في تأبيد شريعة موسى عليه السلام، لأظهر وعد من أقوى العصم. فلما لم يظهروه في زمن عيسى و عصر محمد عليهما السلام، إذ لو أظهروه لتوفرت دواعيهم على نقلهم، فاستبان بذلك، أن ذلك مما اخترعه نابغتهم، و يأبى اللّه إلا أن يتمّ نوره.
فهذا غرضنا من الكلام في النسخ، و قد حان أن نتكلم في معجزة الرسول، بعد ما ثبت جواز النسخ بقضيات العقول.
الأولى بنا تصدير هذا الفصل بما يتعلق بالقرآن و تحقيق كونه معجزا، و مقاصدنا نبينها في معرض أجوبة عن أسئلة.
فإن قال قائل: ما دليلكم على أن نبيكم أظهر القرآن؟ و ما يؤمنكم أن يكون ذلك مختلقا بعده؟
قلنا: لا حجاج في درء الضرورات و نحن باضطرار نعلم أن نبينا عليه السلام كان يدرس القرآن و يتلوه، و يعلمه صحبه و أتباعه، و ما ثبت توترا معلوم على الضرورة. و جحد ذلك بمثابة جحد كون محمد صلى اللّه عليه و سلّم في الدنيا، و هذا كجحد الدول و الوقائع و أيام الماضين. و لا معنى للإطناب في ذلك.
ص: 272
فإن قيل: فإن سلم لكم ظهور ذلك منه في زمانه، فما دليلكم على تحديه به و تعجيزه الأمم بالدعاء إلى معارضته؟ قلنا: هذا أيضا معلوم على الضرورة. فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم لم يزل مدليا بالقرآن، مدلّا به، مدعيا اختصاصه بكتاب اللّه تعالى المنزل عليه. و من أنكر ادعاء استيثاره به، و تعلقه بتخصيص الرب تعالى إياه بكتابه، فقد جحد ما تواترت الأخبار عنه.
و الذي يحقق ما قلناه، أنا على البديهة نعلم أن واحدا من العرب لو أتى- تقديرا- بمثل القرآن، لكان ذلك قادحا فيما يعهد من دعوى النبوءة مزريا به حاطا من رتبته، و هذا ما لا سبيل إلى إنكاره، و لو لا تحديه به لما كان الأمر كذلك. و لا خفاء بما قلناه و قد نصت آي من القرآن على التحدي و تعجيز العرب و منها قوله تعالى: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً [سورة الإسراء: 88]، إلى غيرها من الآي في معناها.
فإن قيل: لا يبعد تقدير الاختلاف في هذه الآي بأعيانها، فإنها لا تبلغ مبلغ الإعجاز فيمتنع تقدير اختراعها. قلنا: ما من آية هي من القرآن إلا و نقلها ثابت على التواتر، إذ تلقاها قراء الخلف عن قراء السلف. و لم يزل الأمر كذلك، ينقله أصاغر عن أكابر، حتى استند النقل إلى قراء الصحابة رضي اللّه عنهم، و ما نقص عدد القراء في كل دهر عن عدد التواتر. و الذي يوضح ما قلناه، أنا لو تشككنا في آية بعينها لاتجه ذلك في كل آية، و ذلك يسقط الثقة بنقل جملة القرآن.
ص: 273
فإن قيل: ما الذي يؤمنكم أن القرآن عورض، ثم كتم ما عورض به؟ قلنا: هذا محال، إذ لو كان ذلك كذلك لظهر الأمر و اشتهر، و الخطب العظيم لا يخفي في مستقر العادة، و ادعاء ما ذكره السائل بمثابة ادعاء خليفة قائم يأمر المسلمين قبل أبي بكر رضي اللّه عنه، و ذلك يعلم بطلانه على الضرورة.
و الذي يعضد ما قلناه، أن الكفرة من لدن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم إلى وقتنا، باذلون كنه مجهودهم في أن ينكئوا في الدين بأقصى الإمكان. فلو كانت المعارضة ممكنة غير متعذرة، لاحتالوا فيها على كرور الدهور و طول العصور، و لو خفيت معارضته لاستجد مثلها.
ثم إن كان هذا السؤال و ضربه من القائلين بالنبوءات، انعكس عليهم جميع ما أوردوه في معجزات نبيهم. فيقال لليهود: ما يؤمنكم أن موسى عليه السلام عورضت آياته، ثم تواضع بنو إسرائيل على طمس الخبر عما جرى من معارضته؟.
فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن العرب ما انكفت عن معارضة القرآن عن عجز، إنما أعجزت عنه بقلة الاكتراث. قلنا: هذا ركيك من القول لا يبوح به من شدا طرفا من الآداب، فإن العرب في تحاورها و تفاوضها، كانت تتشمر إذا تهاجت لمعارضة الركيك من الشعر و الرصين المتين منه. و باضطرار نعلم أن القرآن في اعتقادهم لم ينحط عن شعر لشاعر و نثر لناثر، حتى يحملهم الازدراء به على الانكفاف عن معارضته.
ص: 274
كيف، و قد كان الرسول عليه السلام و أنصاره يقولون: لو عارضتم سورة من القرآن لألقينا إليكم السلم و آثرنا النواجز بعد التناجز، و أذعنا لكم. فإن تكن الأخرى، ألفينا ضرام الحرب، و أدمينا مراسها و أحكمنا أساسها، و مددنا الأيدي إلى قتل النفوس و هتك السّجوف عن العواتق العربيات.
و كيف يخطر لعاقل، و قد ظهرت كلمة الإسلام و خففت على المسلمين الرايات و الأعلام أن يؤثر الكفار أهوالا تشيب النواصي و أحوالا تزيل الرواسي و لا يعارضوا بسورة ازدراء بها.
فقد ثبتت المعجزة و التحدي بها، و العجز من معارضتها، و هذا القدر مغن فيما نريده، و اللّه الموفق للصواب.
فإن قيل: أوضحوا لنا وجه الإعجاز في القرآن، ثم بينوا القدر المعجز منه. قلنا: المرضي عندنا أن القرآن معجز لاجتماع الجزالة مع الأسلوب و النظم المخالف لأساليب كلام العرب. فلا يستقل النظم بالإعجاز على التجريد، و لا تستقل الجزالة أيضا.
و الدليل عليه أنا لو قدرنا الجزالة المحضة معجزة، لم نعدم سؤالا مخيلا. إذ لو قال قائل: إذا قوبل القرآن بخطب العرب و نثرها و أشعارها و أراجيزها، لم ينحط كلام اللّدّ البلغاء و اللّسن الفصحاء عن جزالة القرآن، انحطاطا بينا قاطعا للأوهام. و إن ادعينا الإعجاز في الأسلوب المحض، و النظم المخالف لضروب الكلام، فربما يتجه تقدير نظم ركيك يضاهي نظم القرآن، كما يؤثر من
ص: 275
ترهات مسيلمة الكذاب حيث قال: الفيل ما الفيل، و ما أدراك ما الفيل، له ذنب و ثيل و خرطوم طويل. فلا يعجز عن مثل ذلك، مع الرضى بالركيك و الكلام المرذول الذي تمجه الأسماع. فيلزم من مجموع ما ذكرناه ربط الإعجاز بالنظم البديع مع الجزالة.
فإن قيل: ما وجه البلاغة في القرآن؟ و ما وجه خروج نظمه عن ضروب الكلام؟ قلنا: أما وجه البلاغة فبينة لا خفاء بها. و البلاغة التعبير عن معنى سديد بلفظ شريف ذلق رائق، منبئ عن المقصود من غير مزيد؛ فهذا الكلام الجزل، و المنطق الفصل. ثم البليغ من الكلام تتفنن أقسامه.
فمن جوامع الكلم الدلالة على المعاني الكثيرة بالعبارات الوجيزة، و هذا الضرب لا يعد في القرآن كثرة.
فمنه إنباء اللّه تعالى عن قصص الأولين، و مآل المسرفين و عواقب المهلكين، في شطر من آية، و ذلك قوله عز و جل: فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً، وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ، وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا، وَ ما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ [سورة العنكبوت: 40].
و قال الرب على مفتتح أهل السفينة و إجرائها و إهلاك الكفرة، و استقرار السفينة و استوائها، و توجه أوامر التسخير إلى الأرض و السماء، بقوله تعالى: وَ قالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها، إلى قوله: وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [سورة هود: 41- 44].
ص: 276
و أنبأ عن الموت و حسرة الفوت، و الدار الآخرة و ثوابها و عقابها و فوز الفائزين، و تردي المجرمين، و التحذير من التغرير بالدنيا، و وصفها بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء: بقوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ [سورة آل عمران: 185] الآية.
و من أقسام الكلام البليغ قص القصص من غير انحطاط عن الكلام الجزل، و معظم البلغاء يعلو كلامهم ما شببوا، فإذا لابسوا حكايات الأحوال جاؤوا بالكلام الرث و القول المستغث، و إن حاولوا كلاما جزلا، لم يدرك الكلام مقصده من المعنى.
و هذه قصة يوسف صلى اللّه عليه و سلّم، مع اشتمالها على الأمور المختلفة، و المؤتلفة مسرودة، على أحسن نظام و أبلغ كلام متناسقة الأطراف، متلائمة الأكناف، كأن آياتها آخذ بعضها برقاب بعض. ثم القصص لا تخلو عن التردد و التكرار سيما إذا اتحدت المعاني، و ما لنا نكلف أنفسنا في هذا المعتقد نزف بحر لا ينقص!
و من صدق الآيات على بلاغة القرآن اعتراف العرب قاطبة بها، صريحا و ضمنا؛ فمنهم من اعترف و أفصح، و منهم من سكت و صمت و لو كان في القرآن ما يجانب الجزالة، لكان أحق الناس بالتعريض لنسبته إلى الركاكة أهل اللسان.
فإن قيل: هل في القرآن وجه من الإعجاز غير النظم و البلاغة؟ قلنا: أجل فيها و جهان معجزان:
ص: 277
أحدهما الإنباء عن قصص الأولين على حسب ما ألقي في كتب اللّه تعالى المنزلة، و لم يكن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم ممن عانى تعلما و مارس تلقف كتاب. و كان ينشأ بين ظهراني العرب، و لم تعهد له خرجات يتوقع فيها تلقف علم و دراسة كتاب، و كان في ذلك أصدق آية على صدقه.
و اشتمل القرآن على غيوب تتعلق بالاستقبال و الإخبار عن المغيب، قد يوافق كرّة أو كرّتين، فإذا توالت الأخبار كانت خارقة للعادات. فمن غيوب القرآن قوله تعالى: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ [سورة الإسراء: 88] الآية، و قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا [سورة البقرة: 24] و قوله تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ [سورة الفتح: 47]، و قوله تعالى: الم غُلِبَتِ الرُّومُ [سورة الروم: 1] و قوله تعالى: وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً [سورة الفتح: 20]، إلى غير ذلك مما يطول تعداده.
للرسول صلى اللّه عليه و سلّم آيات لا تحصى سوى القرآن؛ كانشقاق القمر، و إنطاق العجماء، و نبع الماء من خلل الأصابع، و تسبيح الحصى، و تكثير الطعام القليل.
و المرضي عندنا، أن آحاد هذه المعجزات لا تثبت تواترا، لكن مجموعها يفيد العلم قطعا لاختصاصه بخوارق العادات، كما أن آحاد البذل من حاتم لا تثبت تواترا، و لكن مجموعها يفيد العلم على الضرورة بسخائه، و كذلك القول في
ص: 278
جسارة أمير المؤمنين «علي» رضي اللّه عنه، و شجاعته. و أما انشقاق القمر، فقد أنبأت عنه آية من كتاب اللّه ثبت نقلها تواترا، فهذا القدر بالغ كاف فيما نرومه.
اعلموا أن أحق ما يفتتح به الباب، معنى النّبوءة؛ فليست النبوءة راجعة إلى جسم النبي، و لا إلى عرض من أعراضه، و يبطل صرفها إلى علمه بربه إذ ذلك يثبت من غير تقدير النبوءة. و باطل أيضا صرف النبوءة إلى علم النبي بكونه نبيا، فإن المعلوم ما لم يتقرر فلا يتقرر العلم به. فإن كان النبي عالما بنبوءته فما نبوءته؟ و فيها السؤال.
فالنبوءة ترجع إلى قول اللّه تعالى لمن يصطفيه: «أنت رسولي». و هذا بمثابة الأحكام، فإنها ترجع إلى قول اللّه تعالى. و لا تؤول إلى صفات الأفعال، فليس للفعل الواجب صفة لوجوبه نفسية.
بل الفعل المقول فيه: «افعل»، واجب بالقول، و ذلك بمثابة المذكور الذي لا يكتسب من الذكر صفة في نفسه.
فإن قيل: بينوا لنا عصمة الأنبياء و ما يجب لهم. قلنا: يجب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة، و هذا مما نعلمه عقلا، و مدلول المعجزة صدقهم فيما يبلغون. فإن قيل: هل تجب عصمتهم عن المعاصي؟ قلنا: أما الفواحش المؤذنة بالسقوط و قلة الديانة، فتجب عصمة الأنبياء عنها إجماعا.
ص: 279
و لا يشهد لذلك العقل، و إنما يشهد العقل لوجوب العصمة عما يناقض مدلول المعجزة. و أما الذنوب المعدودة من الصغائر، على تفصيل سيأتي الشرح عليه، فلا تنفيها العقول و لم يقم عندي دليل قاطع سمعي على نفيها، و لا على إثباتها. إذ القواطع نصوص أو إجماع، و لا إجماع إذ العلماء مختلفون في تجويز الصغائر على الأنبياء. و النصوص التي تثبت أصولها قطعا، و لا يقبل فحواها التأويل، غير موجودة.
فإن قيل: إذا كانت المسألة مظنونة، فما الأغلب على الظن عندكم؟ قلنا: الأغلب على الظن عندنا جوازها، و قد شهدت أقاصيص الأنبياء في آي من كتاب اللّه تعالى على ذلك. فاللَّه أعلم بالصواب.
فإن قيل: قد استوعبتم ما يليق بالمعتقد في النبوءات، و أضربتم عن الرد على العيسوية. قلنا:
إنما فعلنا ذلك لوضوح تناقض قولهم، بأنهم التزموا شريعته ثم كذبوه، و قد علمنا ضرورة أنه ادعى كونه مبتعثا إلى الثقلين و أرسل دعاته إلى الأكاسرة و ملوك العجم. فوضح بهذا القدر سقوط مذهبهم و نجز به ما لا يسوغ جهله في النبوءات.
اعلموا، وفقكم اللّه تعالى، أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا، و لا يسوغ تقدير إدراكه سمعا؟ و إلى ما يدرك سمعا، و لا يتقدر إدراكه عقلا؛ و إلى ما يجوز إدراكه سمعا و عقلا.
ص: 280
فأما ما لا يدرك إلا عقلا، فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام اللّه تعالى و وجوب اتصافه بكونه صدقا؛ إذ السمعيات تستند إلى كلام اللّه تعالى؛ و ما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبا، فيستحيل أن يكون مدركه السمع.
و أما ما لا يدرك إلا سمعا، فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه، و لا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع. و يتصل بهذا القسم عندنا جملة أحكام التكليف، و قضاياها من التقبيح و التحسين و الإيجاب و الحظر، و الندب و الإباحة.
و أما ما يجوز إدراكه عقلا و سمعا، فهو الذي تدل عليه شواهد العقول، و يتصور ثبوت العلم بكلام اللّه تعالى متقدما عليه. فهذا القسم يتوصل إلى دركه بالسمع و العقل. و نظير هذا القسم إثبات جواز الرؤية، و إثبات استبداد الباري تعالى بالخلق و الاختراع، و ما ضاهاهما مما يندرج تحت الضبط الذي ذكرناه. فأما كون الرؤية و وقوعها فطريق ثبوتها الوعد الصدق و القول الحق.
فإذا ثبتت هذه المقدمة، فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، و كانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها، لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها و لا في تأويلها- فما هذا سبيله- فلا وجه إلا القطع به.
و إن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، و لم يكن مضمونها مستحيلا في العقل، و ثبتت أصولها قطعا، و لكن طريق التأويل يجول فيها، فلا سبيل إلى
ص: 281
القطع؛ و لكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته، و إن لم يكن قاطعا، و إن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل، فهو مردود قطعا بأن الشرع لا يخالف العقل، و لا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع، و لا خفاء به.
فهذه مقدمات السمعيات، لا بد من الإحاطة بها، و نحن الآن نسرد أبوابها تترى، مستعينين باللّه، و نذكر في كل باب ما يليق به من فصول معقودة إن شاء اللّه.
الآجال يعبر بها عن الأوقات، فأجل كل شي ء وقته، و أجل الحياة وقتها المقارن لها، و كذلك أجل الوفاة. فالأوقات في موجب الإطلاقات يعبر بها كثيرا عن حركات الفلك، و ولوج الليل على النهار، و النهار على الليل.
و تحقيق القول في الأوقات أنها لا تتخصص بأجناس من الموجودات، تخصيص الجواهر و العلوم و نحوها، و لكن كل واقع ابتغي أن يقرن بمتجدد، فذلك المتجدد الذي قرن به الحادث وقت له و ذلك إلى قصد المؤقت و إرادته. فإذا قال قائل: قدم زيد عند طلوع الشمس، فقد جعل الطلوع وقتا للقدوم، و إن قال: طلعت الشمس عند قدوم زيد، فقد جعل القدوم وقتا للطلوع.
و الأصل في التوقيت، أن يقدر المؤقت متجددا معلوما، و يفرض فيما يؤقته استبهاما، فيزيل الاستبهام الموهوم بضم ذكره إلى ذكر ما فرض معلوما، ثم
ص: 282
يجوز أن يقدر موجود متجدد وقتا، و يجوز أن يقدر عدم وقتا، إذا تحقق التجدد فيه في مثل قول القائل: تحرك الجوهر عند زوال السواد عنه.
و ذهب بعض القدماء إلى أن كل موجود مفتقر إلى زمان، و قضوا لذلك بثبوت أوقات لا نهاية لها و لا مفتتح، و زعموا أن الباري لم يزل موجودا في أوقات غير متناهية؛ و هذا لا يتحصل، و لا معنى للزمان إلا قرن حادث بمتجدد، أو قرن متجدد بمتجدد.
و قد أقمنا الدليل الواضح على قدم الباري تعالى، و أوضحنا استحالة حوادث لا أول لها، و مقتضى هذين الأصلين يقضي بفساد ما قال هؤلاء، و لو افتقر كل موجود إلى وقت، لافتقرت الأوقات إلى أوقات، ثم يتسلسل القول و يؤدي إلى جهالة، لم يلتزمها أحد من العقلاء.
و الغرض من الباب أن نعلم أن كل من يقتل فقد مات بأجله. و المعنيّ بذلك أن الذي قتل قد علم اللّه تعالى في أزله مآل أمره، و ما علم أنه كائن فلا بد أن يكون فإن قيل: لو قدر عدم القتل فيه، فما قولكم في تقدير موته و بقائه؟
قلنا: ذهب كثير من المعتزلة إلى أنه لو قدر عدم القتل فيه لبقي مدة، و القاتل قاطع بذلك أجله. و ذهب آخرون إلى أنه لو لم يقتل تقديرا، لمات حتف أنفه في الوقت الذي يقدر القتل فيه، و ذلك كله خبط لا محصول له.
و الوجه القطع بأن من علم اللّه تعالى أنه يقتل، لا محالة، فإن قدّر مقدّر عدم القتل، و قدّر معه أن يكون المعلوم أنه لا يقتل فلا يمكن مع هذا التقدير القطع بامتداد العمر، و لا القطع بالموت في وقت القتل بدلا منه، بل كل
ص: 283
جائز ممكن عقلا لا يمتنع تقديره، فهذا ما لا يسوغ غيره، و قد شهدت آي من كتاب اللّه تعالى على أن كل هالك مستوف أجله، منها قوله تعالى: فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ [سورة النحل: 61].
فإن قيل: ما المعنيّ بقوله تعالى: وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ [سورة فاطر: 11].
قلنا: المراد بهذه الآية و جهان من التأويل: أحدهما أن يكون المراد بها، و ما ينقص من عمر شخص من أعمار أضرابه و مبالغ مدة أمثاله، و ليس المراد ينقص عمره الواقع في معلوم اللّه، و كيف يسوغ ذلك، و فيه تقدير علم اللّه تعالى!. و الوجه الثاني، أن تحمل الزيادة و النقصان على المحو و الإثبات المعتورين على صحف الملائكة، و قد يثبت شي ء في صحيفتهم مطلقا، و هو مقيد في معلوم اللّه تعالى، و على ذلك حمل المحققون قول اللّه تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ [سورة الرعد: 39].
و الرزق يتعلق بمرزوق، تعلق النعمة بمنعم عليه، و الذي صح عندنا في معنى الرزق، أن كل ما انتفع به منتفع فهو رزقه، فلا فرق بين أن يكون متعديا بانتفاعه، و بين أن لا يكون متعديا به.
و ذهب بعض المعتزلة إلى أن الرزق هو الملك، و رزق كل موجود ملكه، و قد ألزم هؤلاء أن يكون ملك الباري تعالى رزقا له، من حيث كان ملكا له، فلم يجدوا عن ذلك انفصالا.
ص: 284
و زاد المتأخرون، فقالوا: رزق كل مرزوق ما انتفع به من ملكه و هؤلاء تحرزوا عن ملك الباري تعالى لما قيدوا الملك بالانتفاع، و الرب تعالى متقدس عنه، و يلزمهم مع هذا التقييد، أن يقولوا: لا يدرّ على البهائم رزق اللّه تعالى؛ فإنها لا تتصف بالملك و إن اتصفت بالانتفاع، و قد قال اللّه تعالى: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها [سورة هود: 6]. فإذا بطل ما قالوه، لم يبق إلا صرف الرزق إلى الانتفاع من غير رعاية الملك.
فإن قالوا: هذا الأصل يلزم أن يكون الغصب رزقا للغاصب إذا انتفع به، ثم لا وجه لمنعه من رزقه و دفعه عما رزقه اللّه تعالى، و توجيه اللائمة عليه فيه؛ و هذا الذي استنكروه نص مذهبنا؛ فكل منتفع بشي ء مرزوق به.
ثم الرزق ينقسم إلى المحظور و المباح، و ما ذكروه من أن المرزوق لا يدفع عن رزقه، ممنوع غير مسلم، و ظاهر تشغيبهم يعارضه قولهم: إن القدرة على الإيمان قدرة على الكفر، فالكافر إذا عندهم معان من جهة اللّه تعالى على كفره؛ فإن لم يبعد أن يكون المعاقب بكفره معانا على كفره، لم يبعد ما ذكرناه.
ثم الذي التزموه يجر إلى شناعة لا يبوء بها ذو دين. و ذلك أن من اغتذى بالحرام طول عمره، و انصرفت انتفاعاته إلى الجهات المحظورة من كل وجه، فيلزم أن يقال: لم يدرّ عليه من اللّه رزق، و ما رزقه اللّه قط؛ و ذلك عظيمة لا ينتحلها متدين.
ص: 285
ثم الرزق عندنا ينطلق على ما ينتفع به، إذا تقرر الانتفاع به؛ فهذا مقتضى الإطلاق. و من اتسع ملكه و لم ينتفع به، يقال له: لم يجعل اللّه ما خوله رزقا له، و يتعذر صرف الرزق إلى محض الانتفاع في إطلاق اللسان.
فآل الكلام إلى أن الرزق هو المنتفع به، و إن سمي الانتفاع رزقا، فالمراد به المنتفع به؛ إذ لو جعلنا نفس الانتفاع رزقا، لأخرجنا الأطعمة و الأشربة و الأقوات عن كونها أرزاقا، و ذلك خروج عن موجب اللسان؛ و القول في هذا الباب، و في الذي تقدم عليه، يتعلق بمحض العبارة و التناقش فيها.
الأسعار كلها جارية على حكم اللّه تعالى، و هي إثبات أقدار أبدال الأشياء؛ إذ السعر يتعلق بما لا اختيار للعبد فيه: من عزة الوجود و الرخاء، و صرف الهمم و الدواعي، و تكثير الرغبات و تقليلها، و ما يتعلق فيها باختيار العباد، فهو أيضا فعل اللّه تعالى؛ إذ لا مخترع سواه.
و أطلقت المعتزلة القول بأن السعر من أفعال العباد، و فيما قدمناه في خلق الأعمال مقنع في الرد عليهم.
قد جرى رسم المتكلمين بذكر هذا الباب في الأصول، و هو بمجال الفقهاء أجدر. فالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان بالإجماع على الجملة؛ و لا
ص: 286
يكترث بقول من قال من الروافض: إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، موقوفان على ظهور الإمام فقد أجمع المسلمون، قبل أن ينبغ هؤلاء، على التواصي بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و توبيخ تاركه مع الاقتدار عليه. و لعلنا نذكر لمعا كافية في نقض نصوص الإمامية، إن شاء اللّه.
فإذا ثبت ما قلنا أصلا، فلا يتخصص بالأمر بالمعروف الولاة، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين. و الدليل عليه الإجماع أيضا. فإن غير الولاة من المسلمين في الصدر الأول، و العصر الذي يليه، كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، و ينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم، و ترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف من غير تقلد ولاية.
ثم حكم الشرع ينقسم إلى ما يستوي في إدراكه الخاص و العام، من غير احتياج إلى اجتهاد، و إلى ما يحتاج فيه إلى اجتهاد. فأما ما لا حاجة فيه إلى الاجتهاد، فللعالم و غير العالم الأمر فيه بالمعروف و النهي عن المنكر. و أما ما اختص مدركه بالاجتهاد، فليس للعوام فيه أمر و لا نهي، بل الأمر فيه موكول إلى أهل الاجتهاد.
ثم ليس للمجتهد أن يتعرض بالردع و الزجر على مجتهد آخر، في موضع الخلاف، إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندنا. و من قال إن المصيب واحد، فهو غير متعين عنده، فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين.
ثم الذي يتعاطى الأمر بالمعروف لو لم يكن ورعا، لم ينحسم عنه الأمر بالمعروف؛ إذ ما يتعين عليه في نفسه، فرض متميز عما يتعين عليه الأمر به في
ص: 287
غيره، و لا تعلق لأحد الفرضين بالآخر. ثم الأمر بالمعروف فرض على الكفاية؛ فإذا قام به في كل صقع من فيه غناء، سقط الفرض عن الباقين.
و للآمر بالمعروف أن يصدّ مرتكب الكبيرة بفعله، إن لم يندفع عنها بقوله: و يسوغ لآحاد الرعية ذلك، ما لم ينته الأمر إلى نصب، قتال و شهر سلاح؛ فإن انتهى الأمر إلى ذلك، ربط ذلك الأمر بالسلطان، فاستغنى به. و إذا جار و إلى الوقت، و ظهر ظلمه و غشمه، و لم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل و العقد التواطؤ على درئه، و لو بشهر الأسلحة و نصب الحروب.
و ليس للآمر بالمعروف البحث و التنقير و التجسيس، و اقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيّره جهده.
فهذه عقود الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لا يشذ منها عقد، و تفاصيلها الشرع من مفتتحه إلى مختتمه.
مقصود هذا الباب يحصره فصلان: أحدهما في تثبيت جواز الإعادة، و الثاني في وقوعها.
فأما جواز الإعادة فالعقل يدل عليه، و يدل عليه السمع أيضا، كما ذكرنا (1)في صدر السمعيات.
و كل حادث عدم فإعادته جائزة، و لا فصل بين أن يكون جوهرا أو عرضا.
ص: 288
و ذهب بعض أصحابنا إلى أن الأعراض لا تعاد، بناء على أن المعاد معاد لمعنى، فلو أعيد العرض لقام به معنى. و هذا لا أصل له عند المحققين؛ فإن الإعادة بمثابة النشأة الأولى، و ليس المعاد معادا لمعنى.
و جوزت المعتزلة إعادة الجواهر إذا عدمت، و قسموا الأعراض إلى ما يبقى و إلى ما لا يبقى، و قالوا: ما لا يبقى منها كالأصوات و الإرادات فلا يجوز إعادتها، و كل عرض يستحيل بقاؤه يختص عندهم بوقت لا يجوز تقدير تقدمه عليه، و لا تقدير استيخاره عنه. و أما الباقي من الأعراض، فمنقسم إلى ما كان مقدورا للعبد، و إلى ما لم يكن مقدورا له؛ فأما ما كان مقدورا للعبد، فلا يجوز من العبد إعادته، و لا يصح من القديم أيضا إعادته عندهم. و أما ما لم تتعلق به قدرة العبد، و هو باق من الأعراض، فتجوز إعادته.
فإن سئلنا الدليل على جواز الإعادة استثرناه من نص الكتاب، و فحوى الخطاب، و شبهنا الإعادة بالنشأة الأولى، كما قال تعالى ردا على منكري البعث: قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
و وجه تحرير الدليل أنا لا نقدر الإعادة مخالفة للنشأة الأولى على الضرورة، و لو قدرناها مثلا لها لقضى العقل بتجويزها، فإن ما جاز وجوده جاز مثله، إذ من حكم المثلين أن يتساويا في الواجب و الجائز.
و هذا توسع في الكلام، فإن الإعادة هي المعاد، و المعاد هو بعينه المخلوق أولا، فكيف يقدر الشي ء خلافا لنفسه! و الدلالة تعتضد بأن الأوقات التي هي
ص: 289
مقارنة موجودات لموجودات لا أثر لها.
فما فرض وجوده في وقت لم يمتنع تقديره في غيره.
و هذا لا يستقيم للمعتزلة مع خرمهم أصل الإعادة بمنعها فيما لا يبقى من الأعراض، بأن قالوا: إنما منعنا إعادة ما لا يبقى من الأعراض؛ لأنه لو عاد، و قد سبق له الوجود، لكان موجودا في وقتين؛ و لو جاز وجوده، في وقتين يتخللهما عدم، لجاز وجوده في وقتين متواليين. و هذا الذي ذكروه اقتصار على الدعوى المحضة، و هم بالجمع بينهما مطالبون.
ثم لو استمر الوجود في وقتين، لا تصف العرض بكونه باقيا، و لو بقي العرض كذلك لاستحال عدمه، و ليس كذلك إذا وجد العرض في وقتين بينهما عدم. فإن في كل وقت حادث غير مستمر، و هو مقدور عندنا في حالتي الخلق و الإعادة، و إن كان يمتنع كون الباري مقدورا. ثم يلزمهم إعادة مقدور العبد، فلا يجدون في الانفصال وجها مغنيا، كما ذكرناه في خلق الأعمال، فهذا كلام في جواز الإعادة.
فأما وقوعها فمستدرك بالأدلة السمعية، و قد شهدت القواطع منها على الحشر و النشر، و الانبعاث للعرض و الحساب و الثواب و العقاب. فإن قيل: هل تعدم الجواهر، ثم تعاد؛ أم تبقى و تزول أعراضها المعهودة، ثم تعاد بنيتها؟ قلنا: يجوز كلا الأمرين عقلا، و لم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهما، فلا يبعد أن تصير أجسام العباد على صفة أجسام التراب، ثم يعاد تركيبها إلى ما عهد قبل. و لا نحيل أن يعدم منها شي ء، ثم يعاد، و اللّه أعلم بعواقبها و مآلها.
ص: 290
فمنها إثبات عذاب القبر، و مساءلة منكر و نكير. و الذي صار إليه أهل الحق إثبات ذلك، فإنه من مجوزات العقول، و اللّه مقتدر على إحياء الميت، و أمر الملكين بسؤاله عن ربه و رسوله. و كل ما جوزه العقل، و شهدت له شواهد السمع، لزم الحكم بقبوله، و قد تواترت الأخبار باستعاذة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم بربه من عذاب القبر، و نقل آحاد من الأخبار في ذلك تكلف، ثم لم يزل ذلك مستفيضا في السلف الصالحين، قبل ظهور أهل البدع و الأهواء.
و من الشواهد لذلك من كتاب اللّه تعالى، قوله في قصة فرعون و آله: وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا [سورة غافر: 46]. و هذا نص في إثبات عذاب القبر عليهم قبل الحشر فإنه عز من قائل ذكر ذلك، ثم قال: وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ [سورة غافر: 46].
فإن تمسك نفاة عذاب القبر بمسالك الملحدة المستهزئين بالشرع، و قالوا: نحن نرى الميت الذي ندفنه على حالته، و نعلم على الضرورة كونه ميتا، و لو تركناه صاحيا دهرا لما حال عما عهدناه عليه. و هذا من قائله ملزم بعدم الطمأنينة إلى الإيمان، و الركون إلى الإيقان، و هو بمثابة استبعاد نشر العظام البالية، و تأليف الأجزاء المفترقة، في أجواف السباع، و حواصل الطيور، و أقاصي التخوم، و مدارج الرياح، إلى غير ذلك.
ص: 291
ثم اعلموا أن المرضي عندنا أن السؤال يقع على أجزاء يعلمها اللّه تعالى، من القلب أو غيره فيحييها الرب تعالى، فيتوجه السؤال عليها و ذلك غير مستحيل عقلا، و قد شهدت قواطع السمع به، و ما ذكروه من الإنكار و الإكبار بمثابة إنكار الجاحدين رؤية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم الملائكة مع جلوسه بين أظهرهم.
فإن قيل: بينوا الروح و معناه، فقد ظهر الاختلاف فيه. قلنا: الأظهر عندنا، أن الروح أجسام
لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة، أجرى اللّه تعالى العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكتها لها، فإذا فارقتها يعقب الموت الحياة في استمرار العادة.
ثم الروح من المؤمن يعرج به، و يرفع في حواصل طيور خضر إلى الجنة، و يهبط به إلى سحيق من الكفرة، كما وردت به الآثار. و الحياة عرض تحيا به الجواهر، و الروح يحيا بالحياة أيضا، إن قامت به الحياة. فهذا قولنا في الروح.
الجنة و النار مخلوقتان، إذ لا يحيل العقل خلقهما، و قد شهدت بذلك آي من كتاب اللّه تعالى، منها قوله تعالى: وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [سورة آل عمران: 133] و الإعداد يصرح بثبوت الشي ء و تحققه. و قال
ص: 292
تعالى: وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى. عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى [سورة النجم: 13- 15]. و تواترت الأخبار في قصة آدم عليه السلام، عن الجنة و إدخال آدم إياها، و بدور الزلة منه فيها، و إخراجه عنها، و وعده الرد إليها. و كل ذلك ثابت قطعا، متلقى من فحوى الآيات المستفيض من نقل الأثبات و الثقات.
و قد أنكرت طوائف من المعتزلة خلق الجنة و النار، و زعموا أن لا فائدة في خلقهما قبل يوم الثواب و العقاب، و حملوا ما نصت الآية عليه في قصة آدم عليه السلام على بستان من بساتين الدنيا؛ و هذا تلاعب بالدين، و انسلال عن إجماع المسلمين. و ما هذوا به، من قولهم لا فائدة في خلق الجنة و النار في وقتنا، ساقط لا محصول له. فإن أفعال الباري تعالى لا تحمل على الأغراض على أصول أهل الحق، و هو تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد.
ثم، بم ينكرون على من يقول لهم: علم اللّه تعالى أن خلق الجنة و النار لطف في الإيمان و الأحكام العقلية، و ذلك غير بعيد على موجب قياسهم في اللطف و الصلاح و الأصلح؟
و الصراط ثابت على حسب ما نطق به الحديث، و هو جسر ممدود على متن جهنم، يرده الأولون و الآخرون. و إذا توافرا إليه قيل للملائكة: وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ [سورة الصافات: 24].
ص: 293
و الميزان حق، و كذلك الحوض و الكتب التي يحاسب عليها الخلائق، و لا تحيل العقول شيئا من ذلك. و دلالة السمع ثابتة على قطع في جميع ما ذكرناه.
فإن أبدوا مراء في الصراط، و قالوا: في الحديث المشتمل عليه إنه أدق من الشعر و أحد من السيف، و خطور الخلائق على ما هذا وصفه غير ممكن. و ربما يجحدون الميزان، مصيرا إلى أن الأعمال هي التي يتعلق الثواب و العقاب بها، و هي أعراض لا يتحقق وزنها.
فأما ما ذكروه في الصراط فلا خفاء بسقوطه؛ فإنه لا يستحيل الخطور في الهواء، و المشي على الماء. و كيف ينكر ذلك من يلزمه الدين رغما الاعتراف بقلب العصا حية و فلق البحر، و إحياء الموتى في دار الدنيا. و الموزون الصحف المشتملة على الأعمال، و الرب تعالى يزنها على أقدار أجور الأعمال و ما يتعلق بها من ثوابها و عقابها. فهذا القدر كاف في إرشادكم إلى طريق إثبات السمعيات.
ص: 294
باب في الثواب و العقاب و إحباط الأعمال و الرد على المعتزلة و الخوارج و المرجئة (1) في الوعد و الوعيد
الثواب عند أهل الحق ليس بحق محتوم، و لا جزاء مجزوم، و إنما هو فضل من اللّه تعالى.
و العقاب لا يجب أيضا، و الواقع منه هو عدل من اللّه. و ما وعد اللّه تعالى من الثواب أو توعد به من العقاب، فقوله الحق و وعده الصدق. و كل ما دللنا به على أنه لا واجب على اللّه تعالى، فإنه يطرد هاهنا.
و ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب حتم على اللّه تعالى، و العقاب واجب على مقترف الكبيرة إذا لم يتب عنها. و لا يجب العقاب عند الأكثرين وجوب الثواب؛ لأن الثواب لا يجوز حبطه و العقاب يجوز إسقاطه عند البصريين و طوائف من البغداديين؛ و لكن المعنى بكونه مستحقا عندهم أن يحسن لوقوعه مستحقا، و لو لم يكن كذلك لما حسن العقاب على التأبيد، فهذا حقيقة أصلهم.
فإن ساعدناهم على التقبيح و التحسين عقلا، ألزمناهم على موجب أصلهم أمثلة لا قبل لهم بها. منها، أن السيد إذا كان يقوم بمؤن عبده و إزاحة علله، و العبد يخدمه غير مستفرغ جهده، بل كان مودعا معظم أفعاله فلا يستحق العبد على سيده شيئا على مقابل الخدمة المستحقة عليه. و كذلك المعظم في عشيرته، إذا كان يكرم ولده و يقيم أوده، و الولد يكرمه، و يرعاه و يطلب
ص: 295
مرضاته و يتوخاها، فلا يستوجب بإزاء خدمته مزيدا على ما يناله من الإحسان الدّار عليه.
فإذا كان هذا سبيل من يخدم مثله؛ فالعبد الذي لو قوبلت عبادته بنعماء اللّه تعالى عليه في لحظة، لأبرّت نعماء اللّه تعالى و أربت على جميع قرباته. و الرب تعالى يستحق لأن يعبد، و النعم منه على العباد تترى، و لو حاول العبد عدّها لم يحصها. فكيف يستوجب العبد بالنزر اليسير من أعماله، و هو الغريق في أنعم اللّه تعالى، مزيد ثواب لو لا فضله العظيم!
ثم عبادة العبد شكر للنعم، و ليس من حكم العقل في مستقر العوائد استيجاب عوض على بذل واجب هو عوض. و لو استحق العبد بشكره عوضا، لاستحق الرب تعالى على ما يوليه من الثواب عوضا، و لا محيص عن ذلك.
يقال للمعتزلة: إن سلم لكم استحقاق الثواب، فلم زعمتم أنه يثبت على التأبيد؟ و العبادات الصادرة من المكلفين متناهية، فما بال أعواضها تثبت مع انتفاء النهاية عنها؟
فإن قالوا: إنما كان ذلك، لأن الثواب هو النعيم الهنيّ الخليّ عما ينكده، الصفي عن رنق يكدره، و لو كان الثواب عرضة للزوال لما تهنى به مثاب، مع
ص: 296
علمه بتعرضه للزوال. قلنا لم قلتم إن الثواب يجب على الرتبة العليا في التهني و التخلي عن كل شوب، فعن هذا سئلتم؟
ثم النعم التي يجب على العباد شكرها في دار الدنيا، مشوبة بالمحن و الهموم، و هي على حقائق النعم مع استحقاق شكرها، فلا يبعد ذلك في الثواب أيضا، ثم الرب تعالى مقتدر على أن يلهي المثابين عن ذكر الزوال و التفكر في الانتقال، إلى أن يستوفوا مدتهم؛ فما المانع من ثبوت الثواب مؤقتا مع ما ذكرناه؟
ثم نقول: إن كان هذا قولكم في الثواب، فما قولكم في العقاب؟ فهلا ثبت على التأقيت، و إذا رد الأمر إلى المعهود شاهدا، فباضطرار نعلم أن من بدرت منه بادرة واحدة، ثم قدر له استمرار البقاء، فلا يحسن معاقبته عليها أبدا سرمدا، فما وجه حسن ذلك من أرحم الراحمين، و أكرم الأكرمين؟
فإن قالوا: إنما يخلد اللّه تعالى في النار من علم أنه لو ردّ لعاد لما نهي عنه، قلنا: هذا لا يخلصكم عما ألزمناكموه، و لنا أن نقول بتأقت العقاب، ثم يميت اللّه تعالى من علم أنه لو ردّ لعاد لما نهي عنه، أو يسلبه عقله بعد توفي العقاب عليه، و هذا القدر كاف في غرضنا.
و مما يطالبون به، أن الثواب عندهم لا يقع منه شي ء في دار الدنيا، و لكن يستأخر إلى انقضاء أمد الدنيا، و إلى تصرّم اليوم الثقيل يوم القيامة، و ليس من حكم العقل فينا تأخير المستحق و حبسه عن مستحقه، مع التمكن من أدائه و إيفائه، و مطل الغنى ظلم على لسان صاحب الشرع.
ص: 297
و تعتضد هذه الطلبة، بأن العقاب قد يتنجز منه شي ء في دار الدنيا، إذ الحدود المقامة على مستحقيها عقاب لهم إجماعا. فإذا لم يبعد تنجز شي ء من العقاب، فما المانع من حمل بعض النعم على جهة الثواب، و إن تنحزت في الدنيا؟
ذهبت الخوارج إلى أن من قارف ذنبا واحدا، و لم يوفق للتوبة، حبط عمله و مات مستوجبا للخلود في العذاب الأليم. و صاروا إلى أنه يتصف بكونه كافرا، إذا اجترم ذنبا واحدا. و صارت الأباضية (1) منهم إلى أنه يتصف بالكفر المأخوذ من كفران النعم، و لا يتصف بالكفر الذي هو الشرك.
و ذهبت الأزارقة (2) منهم إلى أن العاصي كافر باللّه تعالى كفر شرك.
و المعتزلة وافقوا الخوارج في المصير إلى استحقاق الخلود، على ما سنفصل مذهبهم.
و لكنهم فارقوا الخوارج من وجهين: أحدهما أنهم لم يصفوا مرتكب الكبيرة بالكفر، و لم يصفوه أيضا بالإيمان، و زعموا أنه على منزلة بين المنزلتين، و رسموه فيها بكونه فاسقا. و فارقوهم من وجه آخر، فقالوا: استحقاق الخلود
ص: 298
في العقاب يختص بالكبائر، و جملة الذنوب كبائر عند الخوارج، و المعتزلة قسموا الذنب إلى الصغائر و الكبائر على ما سنعقد فيه فصلا.
و غرضنا الآن الرد على أصحاب الوعيد، فنقول: من أصلكم أن الوعيد على التأبيد يستحق بزلة واحدة و يحبط لأجلها ثواب الطاعات؛ و ذلك، مع تسليم فاسد أصولكم، في العقول مستحيل، فإن مرجع العقول و مداركها إلى أمثلة الشاهد. و نحن نعلم أن من خدم غيره و بلغ جهده دائما في رعاية حقه مائة سنة فصاعدا، ثم بدرت منه بادرة واحدة، فليس يحسن إحباط جميع حسناته بسيئة واحدة، و إن كان الثواب و العقاب متنافيين، فليس الثواب بأن يحط و يحبط بأولى من العقاب، بأن يسقط، و الشرع يدل على درء السيئات بالحسنات؛ فإحباط العقاب أحق، و قد قال اللّه تعالى: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ [سورة هود: 114].
ثم الطاعات ثابتة على حقائقها، صحيح أداؤها، و الإصرار على الكبيرة لو كان بدرأ ثواب الطاعات، لكان ينافي صحتها؛ كالردة، و مفارقة السنة، فإنها لما كانت محبطة كانت منافية لصحة العبادات. ثم الثواب يستحق على الطاعات عندهم لحسنها و وقوعها طاعات و ذلك يتحقق مع الكبيرة الواحدة تحققه دونها.
فإن قالوا: مرتكب الكبيرة فاسق مخالف، و الجمع بين الثواب و بين سمة الفسوق متناقض؛ فإن الثواب يؤذن بالولاية، و الفسوق ينافيها. قلنا: لا خلاف أنه موصوف بكونه مطيعا بطاعته موقنا موحدا و كل ما ذكرناه من سمات الأولياء. ثم إنما يتناقض اجتماع سمة المشاقّة و الموافقة في الوقت الواحد،
ص: 299
و لا بعد في المخالفة في الشي ء و الموافقة في غيره. ثم إن لم يكن من الإحباط و الإسقاط بدّ فهلّا أحبطتم العقاب و غلبتم الثواب كما قررناه!.
و ربما استدل أصحاب الوعيد بظاهر من الكتاب، و نحن نذكر أغمضها فنرشد إلى طريق الكلام عليه. فمما تمسكوا به قوله تعالى: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها [سورة النساء: 93]، و هذا في ظنهم نص على الوعيد و الخلود. و قد كثر كلام المفسرين في الآية، و ليس من غرضنا استيعاب جميع ما قيل، و لكنا نذكر ما يقنع.
و قد قال ابن عباس في تأويل الآية: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مستحلا قتله، و العمد على الحقيقة إنما يصدر من المستحل؛ فأما من يعتقد أن القتل من أعظم الكبائر فيجرئه هواه و يزعه اعتقاده، فلا يقدم على الأمر إلا خائفا وجلا. و آية ذلك أن الرب تعالى لما ذكر القصاص و وجوبه، لم يقرنه بالوعيد و الخلود؛ و حيث ذكر الخلود لم يتعرض لوجوب القصاص، و ذلك أصدق دلالة على أن التوعد بالخلود للكافر المستحل، الذي لا تجري عليه ظواهر الأحكام. فإن الحربي، الذي لم يلتزم أحكامنا، إذا قتل لم يقض عليه بوجوب القصاص.
ثم إن الخلود، و إن كان ظاهرا في التأبيد، فليس هو نصا فيه، و قد يطلق، و المراد به امتداد مدة و تطاول أمد، و على هذا التأويل يحيّا الملوك بتخليد الملك. و أصحاب الوعيد قاطعون بمعتقدهم، و الظاهر المتعرض للاحتمال لا يفيد القطع.
ص: 300
ثم يعارض استدلالهم بالاحتجاج بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [سورة النساء: 48]، و هذا نص في موضع النزاع، و لا سبيل لهم إلى حمل الآية على التوبة، من وجهين: أحدهما أن قبول التوبة حتم عندهم، فلا يفيد تعلق المغفرة بالمشيئة؛ و الثاني أنه تعالى فرق بين المشرك و بين ما دونه، و التوبة عند الشرك تحبطه و تجبّه، كما أن التوبة عن المعاصي تسقط أوزارها. و يتسع مجال الكلام على الظواهر، و هذا القدر كاف.
جماهير المعتزلة صاروا إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب الطاعات و إن كثرت؛ و ذهب الجبائي و ابنه إلى أن الزلات إنما تحبط ثواب الطاعات إذا أربت عليها، و إن أربت الطاعات درأت السيئات و أحبطتها. ثم لا ينظرون إلى أعداد الطاعات و الزلات؛ و إنما ينظرون إلى مقادير الأجور و الأوزار، فرب كبيرة واحدة يغلب وزرها أجر طاعات كثيرة العدد؛ ثم لا سبيل إلى ضبط مبالغ الأقدار، بل هو موكول إلى علم اللّه تعالى، و اضطربوا في استواء الحسنات و السيئات و لم يثبت لهم في ذلك قدم؛ و قال ابن الجبائي: لا يجوز وقوع ذلك إذ ليس للمكلفين إلا الجنة أو النار، و إذا تساوت أقدار الأعمال، اقتضى تساويها رتبة أخرى.
و كل ما ذكروه خبط لا تحصيل له؛ إذ ليس بإزاء معرفة اللّه تعالى كبيرة يربو وزرها على أجرها، و الأشياء تعرف بأضدادها، فيعلم أجر المعرفة بوزر ضدها؛ فكان من حقهم أن يدرءوا الزلات بالمعرفة؛ فإذا لم يفعلوا ذلك، بطل هذيانهم
ص: 301
بتغالب الأعمال و سقوط أقلها بأكثرها. ثم لا يبعد في العقل أن تكثر طاعات عبد، و تصدر منه زلات و يعاقبه سيده عليها زمنا ثم يرده إلى كرامته، و إن كانت زلاته أقل، و كل ما ذكروه تحكم لا محصول له.
ثم التوبة ندم على ما نصفها، و من سعى في الأرض بالفساد عمره، و ثابر على انتهاك الحرمات دهره؛ فالندم الواحد عليها يحبطها، و إن كان لا يبلغ مبلغها في التعب و النصب؛ فبطل كل ما قالوه.
فإن قيل: قد ردّدتم ذكر الصغائر و الكبائر؛ فميزوا أحد القبيلين عن الثاني. قلنا: المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة، إذ لا تراعى أقدار الذنوب حتى تضاف إلى المعصيّ بها؛ فرب شي ء يعد صغيرة بالإضافة إلى الأقران، و لو صور في حق ملك لكان كبيرة يضرب بها الرقاب. و الرب تعالى أعظم من عصي، و أحق من قصد بالعبادة، و كل ذنب بالإضافة إلى مخالفة الباري عظيم، و لكن الذنوب و إن عظمت بما ذكرناه، فهي متفاوتة على رتبها، فبعضها أعظم من بعض. و هذا كحكمنا للأنبياء بالفضيلة و علو المرتبة، و بعضهم أعلى من بعض؛ فهذا ما نرتضيه.
فإن قيل: من الذنوب ما لا يحط العدالة، و لا يوجب درء الشهادة؛ و منها ما يدرؤها؛ فميزوا ما ينافي العدالة عما لا ينافيها في أحكام الدنيا. قلنا: ليس ذلك الآن من غرضنا؛ و الكلام في الجرح و التعديل من مجال الفقهاء.
ص: 302
ثم نوجز قولا، فنقول: كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، فهي التي تحط العدالة، و كل جريرة لا تؤذن بذلك بل تبقي حسن الظن ظاهرا لصاحبه، فهي التي لا تحط العدالة؛ و هذا أحسن ما يتميز به أحد الضربين عن الآخر.
من مات من المؤمنين على إصراره على المعاصي، فلا يقطع عليه بعقاب، بل أمره مفوض إلى ربه تعالى، فإن عاقبه فذلك بعدله، و إن تجاوز عنه، فذلك بفضله و رحمته، فلا يستنكر ذلك عقلا و شرعا، و هذا مذهب البصريين و بعض البغداديين. و ذهب كثير من معتزلة بغداد، إلى أن العفو غير جائز، و حتم على اللّه أن يعاقب كل مصرّ على الأبد، و هذا الذي قالوه مراغمة للعقل، فلا يخفى حسن الغفران، و التجاوز عن المسي ء، و قد نطق الشرع بذلك و حثّ عليه. فإذا حسن من الواحد منا الصفح، مع تلذذه بالانتقام، و التشفي، و تعرضه للمضار لو كظم غيظه، فلأن يحسن العفو من الرب تعالى، المتنزه عن الحاجة المنعوت بالغنى حقا، أولى و أحرى، و ما ذكروه إبطال لفضل اللّه و رحمته؛ فإنهم أوجبوا عليه ما فعله في الدنيا، و حتموا ما يجري من أحكام العقبى، و لا تبقى مسكة من الدين مع من ينتحل هذا المذهب.
ص: 303
إذا ثبت جواز الغفران، و قد شهدت له شواهد من الكتاب و السنة؛ لم نذكرها لشهرتها، فيترتب على ذلك تشفيع الشفعاء و حط أوزار المجرمين بشفاعتهم.
فمذهب أهل الحق أن الشفاعة حق، و قد أنكرها منكرو الغفران. و من جوز الصفح و العفو بدءا من اللّه تعالى، فلا يمنع الشفاعة، و منهم من يمنعها على مصيره إلى تجويز الغفران؛ و ذلك نهاية في الجهل، لا يلتزمها ذو تحصيل.
و سبيلنا أن نبين أن تشفيع الشفعاء من مجوزات العقول بالطرق التي قدمناها. فإن رددنا الأمر إلى محض الحق، و لم نقل بالتحسين و التقبيح، فالرب تعالى يفعل ما يشاء؛ و إن جاريناهم، وقفونا فاسد معتقدهم، فمرجعهم إلى شواهد الشاهد؛ و لا يقبح عند العقلاء أن يشفّع الملك بعض المخلصين المصطفين لديه في مذنب استحق عقابا، و لا ينكر ذلك إلا متعنت.
فإذا ثبت جواز التشفيع عقلا، فقد شهدت له سنن بلغت الاستفاضة، فمن رامها ألفاها منقولة، ثم هي مصرحة بالتشفيع في أهل الكبائر، إذ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»(1)؛ و قال في الشفاعة: «لا تحسبوها للمتقين، و إنما هي للخاطئين المتلوّثين»؛ و قال: «خيرت
ص: 304
بين الشفاعة و بين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة، فإنها أشفى» (1). و أجمع المسلمون قبل ظهور البدع، على الرغبة إلى اللّه تعالى في أن يرزقهم الشفاعة، و ذلك مجمع عليه في العصور الماضية لا ينكر على مبديه.
فإذا شهد العقل بالجواز، و عضدته شواهد السمع، فلا يبقى بعد ذلك للإنكار مضطرب، و فيما ذكرناه ردّ على فئة صاروا إلى أن الشفاعة ترفع الدرجات و لا تحط السيئات؛ فإن الأخبار المأثورة شاهدة بتعلق الشفاعة بأصحاب الكبائر، و كذلك الرغبات في التشفيع لم تزل تصدر من المتقين و من الخاطئين، و لا يبدو نكير على مبتهل إلى اللّه تعالى في تشفيع نبيّ فيه.
ص: 305
اعلموا أن غرضنا في هذا الفصل يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان، و هذا مما اختلفت فيه مذاهب الإسلاميين.
فذهبت الخوارج إلى أن الإيمان هو الطاعة، و مال إلى ذلك كثير من المعتزلة، و اختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إيمانا. و صار أصحاب الحديث إلى أن الإيمان معرفة بالجنان، و إقرار باللسان، و عمل بالأركان. و ذهب بعض القدماء إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب و الإقرار بها.
و ذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فحسب. و مضمر الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن حقا عندهم، غير أنه يستوجب الخلود في النار. و لو أضمر الإيمان و لم يتفق منه إظهاره، فهو ليس بمؤمن، و له الخلود في الجنة.
و المرضي عندنا، أن حقيقة الإيمان التصديق باللَّه تعالى، فالمؤمن باللَّه من صدقه. ثم التصديق على التحقيق كلام النفس، و لكن لا يثبت إلا مع العلم، فإنا أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد. و الدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللغة و أصل العربية، و هذا لا ينكر فيحتاج إلى إثباته. و في التنزيل: وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَ [سورة يوسف: 17] معناه و ما أنت بمصدق لنا.
ص: 306
ثم الغرض من هذا الفصل، أن من مذهب أهل الحق وصف الفاسق بكونه مؤمنا، و الدليل على تسميته مؤمنا من حيث اللغة أنه مصدق على التحقيق. و آية ذلك في الشرع أن الأحكام الشرعية، المقيدة بخطاب المؤمنين، تتوجه على الفسقة توجّهها على الأتقياء إجماعا، و الفاسق يجري مجرى المؤمن في أحكامه؛ فيسهم له من المغنم، و يصرف إليه سهم المصالح، و يذبّ عنه، و يدفن في مقابر المسلمين، و يصلى عليه، و كل ذلك يقطع بكونه منهم.
ثم إن لم يبعد تسميته عارفا باللَّه تعالى مطيعا له بطاعاته مصدقا إياه، فلا بعد في تسميته مؤمنا، و يبعد جدا أن يقال: هذا عارف باللَّه غير مؤمن به. و الكلام في هذا الفصل يتعلق بالتسميات، و لبابه الوعيد و الخلود، و قد سبق ما فيه مقنع.
و قد يشهد لما ذكرناه إجماع العلماء على افتقار الصلوات و نحوها من العبادات، إلى تقديم الإيمان، فلو كانت أجزاء من الإيمان لا متنع إطلاق ذلك، فإن استدل من سمى الطاعات إيمانا بقوله تعالى: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ [سورة البقرة: 143]؛ قالوا: المراد بذلك، أي بالإيمان الصلوات المؤداة إلى بيت المقدس.
و ربما يستدلون بما روي عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم: «الإيمان بضع و تسعون خصلة، أولها شهادة لا إله إلا اللّه، و آخرها إماطة الأذى عن الطريق» (1). قلنا: أما الإيمان في الآية التي استروحتم إليها، فهو محمول على
ص: 307
التصديق، و المراد: و ما كان اللّه ليضيع تصديقكم نبيكم فيما بلغكم من الصلاة إلى القبلتين و أما الحديث، فهو من الآحاد، ثم هو مؤول؛ و العرب تسمي الشي ء باسم الشي ء إذا دل عليه، أو كان منه بسبب.
فإن قيل: فما قولكم في زيادة الإيمان و نقصانه؟ قلنا: إذا حملنا الإيمان على التصديق، فلا يفضل تصديق تصديقا، كما لا يفضل علم علما؛ و من حمله على الطاعة سرا و علنا؛ و قد مال إليه القلانسي «2»، فلا يبعد على ذلك إطلاق القول بأن الإيمان يزيد بالطاعة، و ينقص بالمعصية، و هذا مما لا نؤثره.
فإن قيل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان منهمك في فسقه؛ كإيمان النبي صلى اللّه عليه و سلّم.
قلنا: النبي عليه الصلاة و السلام يفضل من عداه باستمرار تصديقه، و عصمة اللّه إياه من مخامرة الشكوك، و اختلاج الريب. و التصديق عرض لا يبقى، و هو متوال للنبي عليه الصلاة و السلام، ثابت لغيره في بعض الأوقات، زائل عنه في أوقات الفترات. فيثبت للنبي عليه الصلاة و السلام أعداد من التصديق لا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه بذلك أكثر. فلو وصف الإيمان بالزيادة و النقصان، و أريد بذلك ما ذكرناه، لكان مستقيما، فاعلموه.
فإن قيل: قد أثر عن سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة، و كان إذا سئل الواحد منهم عن إيمانه قال إنه مؤمن إن شاء اللّه، فما محصول ذلك؟ قلنا: الإيمان ثابت
ص: 308
في الحال قطعا لا شك فيه. و لكن الإيمان الذي هو علم الفوز و آية النجاة، إيمان الموافاة؛ فاعتنى السلف به و قرنوه بالمشيئة، و لم يقصدوا التشكك في الإيمان الناجز.
التوبة في حقيقة اللغة الرجوع، يقال: تاب و ناب و أناب إذا رجع. و إذا أضيفت التوبة إلى العبد، أريد بها رجوعه من الزلات إلى الندم عليها، على ما سنحد التوبة في اصطلاح المتكلمين و إذا أضيفت التوبة إلى أفعال اللّه تعالى، فالمراد رجوع نعمه و آلائه إلى عباده.
فإن قيل: حرروا عبارة في حقيقة التوبة على اصطلاحكم. قلنا: التوبة هي الندم على المعصية، لأجل ما يجب الندم له، ثم الندم تلازمه صفات ليست منه عموما، و تلازمه صفات في بعض الأحوال دون بعض فأما الصفات التي تلازم التوبة أبدا، فمنها الحزن و الغم على ما تقدم من الإخلال بحق اللّه تعالى؛ إذ من المحال أن يثبت الندم دون ذلك، و الفرح المسرور بما فرط منه لا يندم عليه. و مما يقارنه تمني عدم ما كان فيما مضى و كل نادم على فعل يجب اتصافه بتمني عدمه فيما مضى.
و مما يقارن التوبة في بعض الأحوال، العزم على ترك معاودة ما ندم المكلف عليه، و ذلك لا يطرد في كل حال؛ إذ إنما يصح العزم من متمكن من فعل ما قدمه؛ و لا يصح من المجبوب العزم على ترك الزنا، و لا من الأخرس العزم على ترك قذف المحصنات. فإن صدر الندم من متمكن من مثل ما ندم عليه،
ص: 309
فلا بد أن يقارن ندمه العزم على ترك معاودته. إذ من المستحيل أن يكون موطنا نفسه على معاودة ما ندم على تقديمه رعاية لحق اللّه تعالى.
فإن قيل: لم قلتم إن التوبة هي الندم؟ قلنا: لأنه الثابت الذي لا يزول في التوبة، و ما عداه يتزايد و يختلف، و منه ما يثبت تارة و ينتفي أخرى. و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم: «الندم توبة»(1) فلزمنا ذلك لمساوقة الخبر و موافقته الأثر. فإن قيل: لم لا يجوز أن يسمى ترك المعصية توبة، من غير ندم؟
قلنا: هذا مما يأباه الشرع. فإن الماجن إذا ملّ مجونه، و استروح إلى بعض المباحات، غير نادم على فارط الزلات، و كان على عزم معاودتها، فهذا يسمى تاركا للزلة، و لا يسمى تائبا عنها.
لا يجب على اللّه تعالى قبول التوبة عقلا، و قد أطبقت المعتزلة على أن قبول التوبة حتم على اللّه، تعالى عن قولهم، و قد سبق الدليل العام في نفي الوجوب
ص: 310
على اللّه تعالى. ثم لو رجعنا إلى الشاهد لم يشهد لوجوب قبول التوبة؛ فإن من أساء مع غيره، و اهتضم حرمته و أبلغ في عداوته، ثم جاء معتذرا، فلا يتحتم في حكم العقل قبول توبته، بل الخيرة إلى من اهتضم و لم يرع حقه؛ فإن شاء صفح، و إن شاء أضرب عنه، و لا شك فيما قلناه.
و الذي يشهد لذلك من السمع، إجماع الأمة على الرغبة إلى اللّه تعالى في قبول التوبة، و الخضوع له في الابتهال إليه رجاء قبولها؛ فلو كان قبول التوبة حتما، لما كان للرغبات و الإلحاح في الدعوات معنى.
فإن قيل: هذا قولكم في العقل و موجبه، فما قولكم في قبول التوبة سمعا، هل ثبت قطعا أم لا؟ قلنا: لم يثبت ذلك عندنا قطعا؛ بل هو مرجوّ مظنون؛ و لم يثبت ظن قاطع لا يقبل التأويل في ذلك، فقطعنا بنفي وجوب القبول عقلا، و لم نقطع بالقبول سمعا و وعدا، بل نظنه ظنا. و يغلب ذلك على الظنون، إذا توفرت على التوبة شرائطها.
التوبة واجبة على العبد، و لا يدل على وجوبها عليه عقل؛ إذ لا يثبت شي ء من الأحكام الشرعية بالعقل. و لكن الدليل عليه إجماع المسلمين على وجوب ترك الزلات و الندم على ما تقدم منها.
ثم التوبة تنقسم: فمنها ما يتعلق بحق اللّه تعالى على التمحض، و منها ما يتعلق بحقوق الآدميين.
ص: 311
فأما ما يتعلق بحق اللّه على التمحض، فيصح دون مراعاة غيره؛ و أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فينقسم؛ فمنه ما لا يصح دون الخروج عن حق الآدميين، و منه ما يصح دونه. فأما ما يصح دونه فهو كل ما يتصور فيه حقيقة الندم مع دوام وجوب حق الآدميين.
و نظير ذلك، القتل الموجب للقود، فيصح الندم عليه، من غير تسليم القاتل نفسه ليستقاد منه. فإذا ندم صحت توبته في حق اللّه تعالى، و كان منعه من القصاص من مستحقه معصية متجددة لا تقدح في التوبة، بل تستدعي في نفسها خروجا عنها، و توبة منها. و ربما تتعلق التوبة بحق الآدميين، و لا تصح دون الخروج منها، و ذلك كاغتصاب شي ء من مال الغير، فلا يصح الندم عليه، مع إدامة شدّ اليد عليه، فلا تتمسكوا بالصور، و ارعوا الندم لحق اللّه تعالى نفيا و إثباتا.
من احتقب أوزارا و قارف ذنوبا صحت توبته عن بعضها، مع الإصرار على بعضها، و ذهب أبو هاشم و متبعوه إلى أن التوبة لا تصح دون الانكفاف عن جميع الذنوب. و هذا الذي ذكروه خروج عن المعقول و موجب الشرع المنقول. فإن من بدرت منه بوادر و صدرت منه عظائم، فيصح في مجرى العادات منه التّنصّل عن جماهيرها، و الاعتذار عنها مع الإصرار على شي ء منها.
و ضرب الأئمة لذلك مثالا، فقالوا: من غصب أموالا لرجل و استولى على جرائم، و انتسب إلى انتهاك حرمات، و كسر له في تضاعيف ما اجترمه قلما. ثم
ص: 312
غرم له ما أتلف، و استسلم لحكمه، و أذعن لأمره، و لكنه لم يعتذر عن كسر القلم؛ فيصح اعتذاره عن العظائم التي ندم عليها، و ذلك غير مجحود عند ذوي العقول.
و الذي يحقق ما قلناه، إجماع الأمة على أن الكافر إذا أسلم و تاب عن كفره، صحت توبته، و إن استدام زلة واحدة. و مذهب أبي هاشم أنه لا تصح توبته، و هو بعد إسلامه، و التزام أحكامه، ملتزم لوزر كفره، و هذا خروج عن إجماع المسلمين. فإن قال من نصر مذهبه إنما يجب التوبة عن الذنب لقبحه، و ذلك يعمم كل ذنب، فلا يصح ندم على قبيح مع الإصرار على قبيح، و هذا الذي ذكروه يبطل من أوجه، يطول تتبعها، و لا يحتمل هذا المعتقد ذكرها.
و لكن مما يقرب في إبطال ما قال، أن الطاعة تثبت لحسنها، فينبغي أن لا تصح طاعة مع ترك طاعة؛ و ليس الأمر كذلك عنده، و كذلك القبيح يترك لقبحه، فينبغي أن لا يتصور ترك قبيح مع مقارفة قبيح و مثابرته. فبطل ما قالوه من كل وجه. ثم التوبة ندم، و يتصور الندم على ضرب، مع غلبة الهوي على ضرب.
من ندم على سيئة و وقع الندم توبة على شرائطها؛ ثم ذكر السيئة، فقد قال القاضي رضي اللّه عنه يجب عليه تجديد الندم عليها، كلما ذكرها. إذ لو لم يندم عليها، لكان مستهينا بها أو فرحا، و ذلك يرده إلى إصراره و يحل عروة الندم.
ص: 313
و هذا ما قاله، ولي فيه نظر. إذ لا يبعد أن يندم، ثم إذا ذكر أضرب عنه و لم يفرح به مبتهجا و لم يجدد عليه ندما؛ و لا خلاف أنه لا يجب عليه استدامة الندم، و استصحاب ذكره دهره جهده؛ و هذا مما نستخير اللّه فيه.
فإن قيل: لو أطاع العبد ثم ندم على الطاعة، فما قولكم فيه؟ قلنا: لا يتصور من العارف باللَّه تعالى أن يندم على طاعته؛ فإن ندم على أمر يرجع إلى نفسه من مضرة لحقته فلا بعد فيه؛ و إنما الذي قلناه الندم على الطاعة من حيث كانت طاعة.
و غرضنا بهذه المقدمة أن القاضي رحمه اللّه أوجب تجديد الندم كما تقدم. ثم قال: إن لم يجدد ندما، كان ذلك معصية جديدة؛ و التوبة الأولى مضت على صحتها، إذ العبادة الماضية لا ينقضها شي ء بعد تصرمها. ثم قال: يجب تجديد ندم على تلك السيئة، و يجب ندم على ترك الندم وقت حكمنا بوجوبه، فهذا قوله.
و عندي أن ذلك من مسائل الاحتمال، و التوبة من العبادات. و لا يجب أن يكون جميع الكلام فيه قطعيا، بل لا يبعد أن يقع فيه مجتهد فيه.
الكافر إذا آمن باللَّه تعالى، فليس إيمانه توبة عن كفره، و إنما ندم على كفره. فإن قيل: فلو آمن و لم يندم على كفره؟ قلنا: ذلك عندنا غير ممكن، بل يجب مقارنة الإيمان الندم على الكفر. ثم وزر الكفر ينحط بالإيمان و الندم على الكفر
ص: 314
إجماعا، و هذا موضع قطع؛ و ما عداه، من ضروب التوبة، فقبوله مظنون غير مقطوع به كما ذكرناه.
من تاب و صحت توبته، ثم عاود الذنب فالتوبة الماضية صحيحة، و الغرض مما ذكرناه أن تعلموا أن التوبة عبادة من العبادات يقضى بصحتها و فسادها. فإذا سيقت على شرائطها، لم يقدح في صحتها ما يقع بعد مضيّها، و على معاود الذنب تجديد التوبة؛ ثم هذه التوبة عبادة أخرى سوى التي ذكرناها. فهذه أصول التوبة ذكرناها و لا يشذ منها مقصد يليق بالمعتقدات.
الكلام في هذا الباب ليس من أصول الاعتقاد، و الخطر على من يزل فيه يربى على الخطر على من يجهل أصله و يعتوره نوعان محظوران عند ذوي الحجاج، أحدهما ميل كل فئة إلى التعصب و تعدي حد الحق، و الثاني من المجتهدات المحتملات التي لا مجال للقطعيات فيها. و قد صنف القاضي و غيره من أئمتنا، رضي اللّه عنه و عنهم، كتبا مبسوطة في الإمامة، و فيها مقنع للمستبصر، و إرشاد بالغ لمن يروم الغاية و درك النهاية.
ص: 315
و غرضنا في هذا المعتقد، أن ننص على أصول الباب، فنذكر القواطع منها، و نميز المجتهدات عن القطعيات، مستعينين باللَّه تعالى. و الترتيب يقضي تقديم طرف من الكلام في الأخبار و منازلها، فإنها مبنى الإمامة.
ص: 316
فإن قيل: اذكروا حقيقة الخبر أولا، ثم فصّلوه. قلنا: الخبر ما يوصف بالصدق أو الكذب، و هذا يميزه مما عداه من الكلام، و يميزه عن أقسام الكلام أيضا. فإن الأمر، و النهي، و التلهف، و الاستخبار و نحوها، لا يوصف شي ء منها بالصدق و لا بالكذب.
ثم الخبر ينقسم: فمنه ما يعلم صدقه قطعا، و منه ما يعلم كونه كذبا قطعا، و منه ما يجوز فيه تقدير الصدق أو الكذب، فأما الخبر الصدق قطعا، فما وافق مخبره المعلوم قطعا، بضرورة أو دليل قاطع، كالخبر عن المحسوسات على ما هي عليه، و الخبر عن كل ما يعلم ضرورة. و يتصل بذلك الخبر عما يعلم نظرا إذا وافق مخبره المعلوم. و ما علم كونه كذبا قطعا فهو ما يخالف مخبره المعلوم ضرورة و نظرا فهو كالإخبار عن المحسوسات على خلاف حكم تعلق الحواس بها، و كالإخبار عن قدم العالم مع قيام الأدلة القاطعة على حدثه. و ما يتردد من الأخبار، فهو ما يتعلق بجائز لا يستحيل فيه تقدير النفي و لا تقدير الإثبات.
ثم ينقسم الخبر بعد ذلك انقساما هو غرضنا، فمنه ما لا يترتب عليه العلم بالمخبر عنه، و منه ما يترتب عليه العلم بالمخبر عنه. فأما ما يعقب علما بمخبره، فهو الخبر المتواتر؛ فإذا توافرت شرائطه و تكاملت صفاته، استعقب العلم بالمخبر عنه على الضرورة. و به نعلم البلاد النائية التي لم نشهدها، و الوقائع و الدول التي لم تقع في عصرنا، و به تتميز في حق الإنسان والدته عن غيرها من النساء. و جاحد العلم بذلك جاحد للضرورة و متشكك في المعلوم على البديهة.
ص: 317
ثم الخبر المتواتر لا يوجب العلم بالمخبر عنه لعينه، و إنما سبيل إفضائه إلى العلم بالمخبر عنه استمرار العادات. و من جائزات العقول أن يخرق اللّه العادة، فلا يخلق العلم بالمخبر عنه، و إن تواترت الأخبار عنه، و كذلك يجوز على خلاف العوائد أن يخلق العلم الضروري على أثر إخبار الواحد، و لكن العادات مستمرة على حسب ما ذكرناه.
فإن رام متعسّف قدحا، و قال: كل واحد من المخبرين، لو انفرد بإخباره لم يفد علما، و انضمام خبر غيره إلى خبره لا يحيل حكم خبره؛ فيلزم أن لا يفيد مجموع الإخبار ما لم يفده الخبر الواحد. و هذا الذي ذكروه لا تحصيل له؛ فإنا أوضحنا أن الخبر المتواتر لا يوجب العلم بالمخبر عنه، و إنما يعقبه العلم مع استمرار العادة ما ثبتت مستمرة، و إنما استمرت العادة، كما ذكرناه عند إخبار عدد التواتر. و نظير ذلك من مستمر العادة أنه لا يبعد قيام شخص واحد في وقت معين؛ و لو قيل قام في هذا الوقت عدد كثير و جم غفير لا يحصون من غير تواطؤ منهم، و لا مسّتهم حاجة، و دعتهم داعية إلى القيام عامة؛ فيعلم أن هذا الخبر خلف؛ فإنه على خلاف العادة، و هو بمثابة الخبر عن انقلاب الجبال ذهبا إلى غير ذلك.
ثم إنما يثبت التواتر بشرائط. فمنها أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا عنه على الضرورة؛ مثل أن يخبروا عن محسوس أو معلوم بديهة بجهة أخرى، سوى درك الحواس. و لو أخبروا عما علموه، نظرا و استدلالا، لم توجب أخبارهم علما؛ فإن المخبرين عن حدث العالم زائدون عن عدد التواتر، و ليس يوجب خبرهم علما، و المخبرون تواترا عن بلدة لم نرها مصدقون على الضرورة، و ليس
ص: 318
ذلك مما نحاول فيه تعليلا، أو نظرا، أو فرقا، أو دليلا، و لكنا بينا أن مأخذ العلم بالمخبر عنه استمرار العادة. و قد رأينا العادة مستمرة على ما ذكرناه في المخبر عنه على الضرورة، دون المخبر عنه نظرا، فجرينا على موجب العادة في النفي و الإثبات.
و الشرط الثاني للخبر المتواتر أن يصدر عن أقوام يزيد عددهم على مبلغ يتوقع منه التواطؤ في العرف المستمر، و لو تواطأ و مثلا لظهر على طول الدهر تواطؤهم. و لسنا نضبط في ذلك عددا هو الأقل، و لكنا نعلم أن كل عدد شرط في شهادة شرعية، فعدد التواتر يربى عليه. و نهاية العدد في الشهادة الشرعية أربعة، فنعلم قطعا أن إخبار الأربعة. لا يعقب العلم الضروري بالمخبر عنه، إذ لو كان يعقبه، لكان يضطر الحاكم عند شهادة الشهود إلى العلم بصدقهم، و ليس الأمر كذلك.
ثم الذي أرتضيه أنه لا يحصل العلم بإخبار خمسة أيضا، فإن الشهود في مجلس القاضي لو استظهروا بشهادة خامس، أو سادس، لم يحصل العلم الضروري بما أخبروا عنه. و لسنا نحدّ حدّا في الأقل؛ إذ الشرع، كما ورد بتحديد الشهود؛ فكذلك ورد بالاستكثار من زيادة الشهود.
و إن رام ذو تحصيل في ذلك ضبطا، فليفرض خبر واحد عن محسوس، ثم خبر اثنين، ثم كذلك، فزايدا صاعدا؛ و هو في ذلك كله يعلم ما بطرقه من الرّيب و غلبات الظنون حتى ينتهي الأمر إلى العلم الضروري. فإذا أدركه، و انتفى عنه كل ريب، ضبط العدة في المخبرين، و قدر أقل عدد التواتر، ثم نفرض ما ذكرناه في صادقين مخبرين عما علموه ضرورة؛ فإن اتفق مثل هذا
ص: 319
العدد غير موجب للعلم، فذلك لتخلل كاذبين يحط أقل عدد التواتر، و في ذلك مجال رحب للكلام لا سبيل للخوض فيه هاهنا.
ثم إن كان المخبرون أنبئوا عما شاهدوه و علموه ضرورة من غير واسطة، فالكلام كما ذكرناه، و إن نقلوا ما أنبئوا عنه عن آخرين و نقل أولئك عن متقدمين، و تناسخت الأعصار، و تواترت الأخبار؛ فلا يحصل العلم الضروري بالمقصود من الخبر إلا عند استواء طرفي المخبرين و واسطتهم، و المعنيّ بذلك: أن يكون المخبرون عن المقصود أولا على عدد التواتر، و كذلك المخبرون عنهم، إلى أن يتصل الخبر بنا، فلو انخرم شرط من شرائط التواتر في الأول، أو في الآخر؛ أو في الوسائط، لم يحصل العلم بالمخبر عنه المقصود بالخبر.
و لا يشترط عدالة المخبرين على التواتر، و لا إيمانهم. فإن الأخبار إذا تواترت من الكفار في بلدهم بأن ملكهم قد قتل فنضطر إلى صدقهم و إذا أخبروا عن ذلك في أقاصي ديارهم، علمنا صدقهم عند شرائط التواتر و لا يشترط أن يكون المخبرون على تنائي الديار. فإن أهل البلدة الواحدة إذا أخبرونا. و هم الجم الغفير، علمنا صدقهم، و إن كانت البلدة جامعة لهم. و بمثل ذلك لا يشترط أن يشتمل المخبرون على أهل الملل فإن أهل بغداد مثلا لو أخرجوا من بين أظهرهم كل ذمي، ثم أخبروا عن واقعة جرت، فإنا نصدقهم مع تمسكهم بالملة الواحدة، و بمثل ذلك يعلم أن المخبرين يجوز أن يكونوا تحت ذمة.
و قصدنا بما أشرنا إليه من نفي هذه الشرائط، الرد على اليهود، فإنهم ربما يشترطون هذه الشروط، و يحاولون بها القدح فيما نروم إثباته من معجزات رسولنا صلى اللّه عليه و سلّم، فهذا القدر غرضنا من خبر التواتر.
ص: 320
و كل خبر لم يبلغ مبلغ التواتر فلا يفيد علما بنفسه، إلا أن يقترن به ما يوجب تصديقه مثل أن يوافق دليلا عقليا، أو تؤيده معجزة، أو قول مؤيد بمعجزة تصدقه. و كذلك إذا تلقت الأمة خبرا بالقبول، و أجمعوا على صدقه. فنعلم صدقه. فإن فقد ما ذكرناه، و لم يكن الخبر متواترا، فهو المسمي، خبر الواحد في اصطلاح المتكلمين؛ و إن نقله جمع.
و مما تترتب عليه الإمامة القطع بصحة الإجماع؛ و هذا ما لا مطمع في تقريره هاهنا، و قد ذكرناه في كتاب التلخيص في أصول الفقه ما يدل على صحة الإجماع؛ و لكنا نعضد هذا المعتقد بقاطع في صحة إثبات الإجماع، جريا على ما التزمناه من إيراد القواطع، في كل ركن فنقول:
إذا أجمع علماء الأمصار على حكم شرعي، و قطعوا به، فلا يخلو ذلك الحكم إما أن يكون مظنونا لا يتوصل إلى العلم به، و إما أن يكون مقطوعا به؛ فإن كان مقطوعا به على حسب اتفاقهم، فهو المقصود؛ و إن كان مظنونا لا سبيل إلى العلم به، فيستحيل في مستقر العادة أن يحسب العلماء بطرق الظنون و العلوم الظن علما مطبقين عليه، من غير أن يختلج لطائفة شك أو يخامرهم ريب، و تقدير ذلك خرق للعادة.
فإن قيل: إذا تحزب العلماء حزبين، فحلل حزب و حرم حزب، و كل حزب زائدون على عدد التواتر، و هم مصممون على اعتقادهم.
ص: 321
قلنا: إذا كانت المسألة مختلفا فيها، فكل حزب معترفون بأن معتقدهم مظنون، و إنما كلامنا في إجماع العلماء على قطع في مظنون، و هذا خرق للعادة لا شك فيه.
فإن قيل: فاجعلوا إجماع العقلاء دليلا على صدقهم بمثل ما ذكرتموه. قلنا قد كلفنا في الشرع أن نسند العقود إلى الأدلة العقلية، و الإجماع و إن قدر مؤديا إلى العلم بمسلك العادات و استقرارها، فهي متعرضة للانخراق في مجوزات العقول، فلزم التزام ما كلفناه من المباحثة على الأدلة العقلية.
ثم هي شتى لا يضبط مأخذها إلا حبر مبرز و تعارضها شبه كثيرة مخيلة لا ينفصل عنها إلا موفق و القاطع السمعي لا تتعدد جهاته، و إنما هو نص ثبت أصله و فحواه قطعا، و لا يتلقى القطع من غيره.
فإذا صادفناهم مجمعين على القطع، مع اتحاد وجه القطع، قطعنا بصدقهم.
و الذي عندي أن إجماع علماء سائر الأمم في الأحكام على موجب ما طردناه يوجب العلم جريا على مستقر العادة و هذا أحسن بالغ، و سنبسطه في كتاب الشامل إن شاء اللّه تعالى، و نذكر طرقا مستحسنة في الإجماع إن شاء اللّه عز و جل، و قد حان أن نخوض في الإمامة.
ذهبت الإمامية إلى أن النبي صلى اللّه عليه و سلّم نص على تولية علي عليه السلام على الإمامة بعده، و أن من تولاها ظالمه و كان مستأثرا بحقه.
ص: 322
فنقول لهؤلاء: أ تعلمون أن النص عليه ثابت، أم تجوزونه؟ فإن علمتموه فما الطريق إليه؟
و العقل لا يقضي تنصيصا على شخص معين. فإن ردوا ما ادعوه من العلم إلى الخبر، قيل لهم:
الخبر ينقسم إلى ما يتواتر، و إلى ما يعد من الآحاد؛ و ليس معكم نص منقول على التواتر، و خبر الواحد لا يعقب العلم. فمن أي وجه ادعيتم العلم بالنص؟ و قد أطبقت الإمامية على أن أخبار الآحاد لا توجب العمل، فضلا عن العلم.
فإن تعسف متعسف، و ادعى التواتر و العلم الضروري بالنص على عليّ رضي اللّه عنه، فذلك بهت، و هو دأب الروافض. فيجب أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم في النص على أبي بكر رضي اللّه عنه. ثم لا شك في تصميم من عدا الإمامية على نفي النص، و العلم الضروري لا يجمع على نفيه من ينحط عن معشار أعداد مخالفي الإمامية. و لو جاز رد الضروري في ذلك، لجاز أن ينكر طائفة بغداد و البصرة و الصين الأقصى و غيرها، و ذلك يغني بوضوحه عن كشفه.
فإن قيل: قد أبديتم قاطعا في منع الإمامية من ادعاء النص، فهل تعلمون عدم النص على عليّ عليه السلام؛ أم تستريبون فيه؟ قلنا: إن ادعى الإمامية نصا جليا على عليّ عليه السلام في مشهد من الصاحبة و محفل عظيم، فنعلم قطعا بطلان هذه الدعوى. فإن مثل هذا الأمر العظيم لا ينكتم في مستقرّ العادة، كما لم ينكتم تولية رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم معاذا اليمن، و زيدا و أسامة بن زيد، و عقد الولاية لهم، و تفويض الجيوش إليهم، و اجتباء الأخرجة إلى بعضهم. و كما لم يخف تولية أبي بكر عمر، و جعل عمر الأمر شورى بينهم، و لو
ص: 323
جوزنا انكتام هذه الأمور الظاهرة، لم نأمن من أن يكون القرآن عورض ثم كتمت معارضته، و كل أصل في الإمامة يكر على إبطال النبوءة فهو حري بالإبطال.
فهذا إن ادعوا نصا شائعا لا اعتلال فيه، فيضطر إلى استحالة كتمانه و ترك اللهج به، سيما في عصر أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم، و قرب العهد بالنص المدعى، و الاختلاف في عين الإمام يوم السقيفة.
و إن ادعوا نصا خفيا غير مظهر، فنعلم أنه لا سبيل إلى علمه، ثم نعلم بطلانه بالإجماع على خلافه؛ مع ثبوت الإجماع مقطوعا به، و بذلك ندرأ سؤال من قال: خبر الواحد إن لم يوجب العلم فهو موجب للعمل، فاعملوا بما نقلناه. قلنا: ما نقلتموه لا نستجيز قبوله، و أحسن أحوالكم عندنا الضلالة، و معظمكم مكفرون، فكيف تسوموننا قبول أخباركم؛ و لا نستريب في أنكم لا تقبلون خبرنا! ثم الإجماع أحق أن يعمل به، و قد انعقد على خلاف ما ادعيتم في عصر أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم.
و من الإمامية من استشعر الخزي و أيس من ادعاء النص القاطع الذي لا يحتمل التأويل، و تشبث بأخبار نقلها آحاد غير إثبات منها ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم أنه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و من كنت مولاه فعلي مولاه» «1». قلنا: هذا من أخبار الآحاد، ثم هو منكر للاحتمالات؛ إذ المولى من الأسماء المشتركة، فقد يراد به الوليّ، و قد يراد به الناصر، و هو أظهر معانيه. و قد يراد به المعتق. و المعني بالحديث من كنت ناصره فعليّ ناصره. و الدليل عليه أنه لم يخصص ذلك بما بعد وفاته؛ بل قضى بما قاله ناجزا؛ و لا شك أنه لم
ص: 324
يكن والي الأمر في حياة النبي صلى اللّه عليه و سلّم. و قد كثر كلام الناس على هذا الحديث، و معظمه حشو، و فيما ذكرناه مقنع.
و ربما يستروحون إلى ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم، أنه قال لعليّ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» (1). و لا حجة لهم في ذلك؛ فإنه وارد على سبب مخصوص، و هو أن النبي صلى اللّه عليه و سلّم لما نهض لغزوة تبوك، استخلف عليا رضي اللّه عنه على المدينة، و شقّ عليه تخلفه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم؛ فقال له الرسول ما قال، و أنزله منزلة هارون من موسى في الاستخلاف إذ مرّ موسى لميقاته ثم لم يل هارون أمرا بعد وفاة موسى بل مات قبله في التّيه.
ثم نعارض ما ذكروه بأخبار تداني النصوص في حق أبي بكر و عمر رضي اللّه عنهما؛ منها أنه صلى اللّه عليه و سلّم استخلف أبا بكر على الصلاة، ثم قال: «يأبى اللّه و المسلمون إلا أبا بكر»(2) قاله ثلاثا؛ و قال:
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر و عمر» (3). و ليس من غرضنا نقل الأحاديث، فستلقونها في الكتب.
ثم إذا بطل النص لم يبق إلا الاختيار، و الدليل عليه الإجماع، فإن الاختيار جري في أعصار، و لم يبد نكير من عالم على أصل الاختيار.
ص: 325
اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة و إن لم تجمع الأمة على عقدها. و الدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين و لم يتأنّ لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار، و لم ينكر عليه منكر، و لم يحمله على التريث حامل.
فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة، لم يثبت عدد معدود، و لا حدّ محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد، من أهل الحلّ و العقد.
ثم قال بعض أصحابنا: لا بد من جريان العقد بمشهد من الشهود؛ فإنه لو لم يشترط ذلك، لم نأمن أن يدعي مدع عقدا سرا متقدما على الحق المظهر المعلن. و ليست الإمامة أحط رتبة من النكاح، و قد شرط فيه الإعلان، و لا يبلغ القطع، إذ ليس يشهد له عقل، و لا يدل عليه قاطع سمعي، و سبيله سبيل سائر المجتهدات.
ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي العالم. ثم قالوا: لو اتفق عقد عاقدي الإمامة لشخصين لنزل ذلك منزلة تزويج و ليين امرأة من زوجين، من غير أن يشعر أحد بعقد الآخر.
ثم التفصيل فيه من فن الفقه. و الذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط و
ص: 326
المخالف غير جائز، و قد حصل الإجماع عليه. و أما إذا بعد المدى و تخلل بين الإمامين شسوع النوى فللاحتمال في ذلك مجال، و هو خارج عن القواطع.
من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، و لا يجوز خلعه من غير حدث و تغير أمر، و هذا مجمع عليه. فأما إذا فسق و فجر، و خرج عن سمت الإمامة بفسقه، فانخلاعه من غير خلع ممكن، و إن لم يحكم بانخلاعه، و جواز خلعه، و امتناع ذلك، و تقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقويم سبيلا، و كل ذلك من المجتهدات عندنا فاعلموه.
و خلع الإمام نفسه من غير سبب محتمل أيضا. و ما روي من خلع الحسن عليه السلام نفسه فذلك ممكن حمله على استشعاره عجزا من نفسه، و يمكن حمله على غير ذلك.
من شرائط الإمام أن يكون من أهل الاجتهاد، بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث و هذا متفق عليه. و من شرائط الإمامة أيضا أن يكون الإمام متصديا إلى مصالح الأمور و ضبطها، ذا نجدة في تجهيز الجيوش و سد الثغور، و ذا رأي حصيف في النظر للمسلمين. لا ترعه هوادة نفس و خور طبيعة عن
ص: 327
ضرب الرقاب و التنكيل بمستوجبي الحدود. و يجمع ما ذكرناه الكفاية، و هي مشروطة إجماعا.
و من شرائطها عند أصحابنا، أن يكون الإمام من قريش إذ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم: «الأئمة من قريش» (1)، و قال: «قدموا قريشا و لا تقدموها»(2). و هذا مما يخالف فيه بعض الناس، و للاحتمال فيه عندي مجال، و اللّه أعلم بالصواب.
و لا خفاء باشتراط حرية الإمام و إسلامه. و أجمعوا أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما، و إن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما يجوز شهادتها فيه.
أما إمامة أبي بكر رضي اللّه عنه فقد ثبتت بإجماع الصحابة فإنهم أطبقوا على بذل الطاعة و الانقياد لحكمه، و استوى في ذلك من يعتزي الروافض إلى التكذب عليه و غيرهم؛ فإن أبا ذرّ، و عمارا، و صهيبا، و غيرهم، من الذين كانوا لا تأخذهم في اللّه لومة لائم، اندرجوا تحت الطاعة على بكرة أبيهم. و كان علي رضي اللّه عنه مطيعا له، سامعا لأمره، ناهضا إلى غزوة بني حنيفة، متسرّيا بالجارية المغنومة من مغنمهم.
ص: 328
و ما تخرص به الروافض، من إبداء على شراسا و شماسا في عقد البيعة له، كذب صريح. نعم لم يكن رضي اللّه عنه في السقيفة؛ و كان مستخليا بنفسه، قد استفزه الحزن على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم. ثم دخل فيما دخل الناس فيه، و بايع أبا بكر على ملأ من الإشهاد.
فإن قيل: دلّوا على كونه مستجمعا لشرائط الإمامة. قلنا: في ذلك مسلكان: أحدهما الاجتزاء بالإجماع على إمامته، و لو لم يكن صالحا لها، لما أجمعوا على اتصافه بها؛ ثم إن فصلنا، و هي الطريقة الثانية، قلنا: من شرائط الإمامة عند أقوام كون الإمام من قريش. و قد كان رضي اللّه عنه من صميمها. و من شرائطها العلم و نحن على اضطرار نعلم أنه كان من أحبار الصحابة و مفتيهم، لا ينكر عليه أحد في تصديه للتحليل و التحريم. و أما الورع فنقطع به في زمن النبي صلى اللّه عليه و سلّم، و يعلم دوامه، إذ لم يثبت قادح فيه مقطوع به، و إجماع الصحابة على إمامته مع تشميرهم للبحث عن الدين أصدق آية على ورعه؛ و ورعه نقل إلينا نقل جود حاتم،(1) و شجاعة عمرو بن معدي كرب، و غيرهما، فلا معنى للمماراة فيه؛ و أما شهامته و كفايته، فقد شهدت بها عليه أثاره، و دلت عليها سيرته.
و أما عمر و عثمان و عليّ، رضوان اللّه عليهم؛ فسبيل إثبات إمامتهم و استجماعهم لشرائط الإمامة كسبيل إثبات إمامة أبي بكر، و مرجع كل قاطع في الإمامة إلى الخبر المتواتر و الإجماع؛ و غرضنا الآن الإيجاز، و لو تدبر العاقل لاكتفى بما ذكرناه، و استيقن أن فيه أكمل غنية.
ص: 329
و تولية أبي بكر عمر رضي اللّه عنهما، و جعله إياه وليّ عهده، و جعل عمر الأمر بينهم شورى من غير إنكار عليهما، إجماع على تصحيح ذلك في سائر الأعصار، و لا اكتراث بقول من يقول لم يحصل إجماع على إمامة عليّ رضي اللّه عنه، فإن الإمامة لم تجحد له، و إنما هاجت الفتن لأمور أخر.
فإن قيل: هل تفضلون بعض الصحابة على بعض، أم تضربون عن التفضيل؟ قلنا: الغرض من ذلك ينبني على منع إمامة المفضول. و الذي صار إليه معظم أهل السنة أنه يتعين للإمامة أفضل أهل العصر إلا أن يكون في نصبه هرج و هيجان فتن، فيجوز نصب المفضول إذ ذاك إذا كان مستحقا للإمامة، و هذه المسألة لا أراها قطعية، و لا معتصم لمن يمنع إمامة المفضول إلا أخبار آحاد في غير الإمامة التي نتكلم فيها، كقوله صلى اللّه عليه و سلّم: «يؤمكم أقرؤكم»(1). و لا يفضي هذا و أمثاله إلى القطع، كيف و لو تقدم المفضول في إمامة الصلاة لصحت الإمامة و إن ترك الأولى! فهذا قولنا في إمامة المفضول.
ثم لم يقم عندنا دليل قاطع على تفضيل بعض الأئمة على بعض، إذ العقل لا يشهد على ذلك، و الأخبار الواردة في فضائلهم متعارضة لا يمكن تلقي التفضيل من منع إمامة المفضول. و لكن الغالب على الظن أن أبا بكر رضي اللّه عنه أفضل الخلائق بعد الرسول صلى اللّه عليه و سلّم، ثم عمر بعده أفضلهم،
ص: 330
و تتعارض الظنون في عثمان و علي، و قد روي عن عليّ رضي اللّه عنه أنه قال: خير الناس بعد نبيهم أبو بكر، ثم عمر، ثم اللّه أعلم بخيرهم بعدهما. فهذا هو قوله أبديناه مجانبا للتقليد، جاريا على الحق الواضح.
قتل عثمان بن عفان رضي اللّه عنه ظلما، إذ كان إماما، و موجبات القتل مضبوطة عند العلماء، و لم يجر عليه منها ما يوجب قتله. ثم تولى قتله، همج، و رعاع، و أشابة من كل أوب، و أخياف من سفلة الأطراف كالتجيبي «1»، و الأشتر النخعي «2»، و أراذلة من خزاعة، و من يستحق القتل، فليس إلى هؤلاء قتله، فلا يشك فيه أنه قتل مظلوما.
قد كثرت المطاعن على أئمة الصحابة، و عظم افتراء الرافضة، و تخرصهم. و الذي يجب على المعتقد أن يلتزمه، أن يعلم أن جلة الصحابة كانوا من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم بالمحل المغبوط و المكان المحوط. و ما منهم إلا و هو منه ملحوظ محظوظ. و قد شهدت نصوص الكتاب على عدالتهم و الرضا عن جملتهم بالبيعة بيعة الرضوان و نص القرائن على حسن الثناء على المهاجرين و الأنصار.
ص: 331
فحقيق على المتدين، أن يستصحب لهم ما كانوا عليه في دهر الرسول صلى اللّه عليه و سلّم، فإن نقلت هناة فليتدبر النقل و طريقه، فإن ضعف رده؛ و إن ظهر و كان آحادا، لم يقدح فيما علم تواترا منه و شهدت له النصوص. ثم ينبغي أن لا يألوا جهدا في حمل كل ما ينقل على وجه الخبر، و لا يكاد ذو دين يعدم ذلك. فهذا هو الأصل المغني عن التفصيل و التطويل.
عليّ بن أبي طالب كان إماما حقا في توليته، و مقاتلوه بغاة، و حسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد الخير و إن أخطئوه. و عائشة رضي اللّه عنها قصدت بالمسير إلى البصرة تسكين الثائرة و تطفئة نار الفتن، و قد اشرأبت للاضطرام، فكان من الأمر ما كان.
و لا يعصم واحد من الصحابة عن زلل، و اللّه وليّ التجاوز بمنه و فضله. و كيف يشترط العصمة لآحاد الناس، و هي غير مشروطة لإمام! و لا يكترث بقول من يشترط العصمة للأئمة من الإمامية، فإن العقل لا يقضي باشتراطها. و كل ما يحاولون به إثبات عصمة الإمام يلزمهم عصمة ولاته و قضاته و جباته للأخرجة.
فهذه رحمكم اللّه و أصلح بالكم، قواطع في قواعد العقائد، يستقل بها المبتدي، و يتشوق بها المنتهي إلى جلة المصنفات. و قد تصرمت بعون اللّه و تأييده و الحمد للَّه المشكور على إفضاله، و صلى اللّه على محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و على آله الطيبين و صحبه الأكرمين و سلم تسليما.
ص: 332
تمّ بحمد اللّه تعالى كتاب الإرشاد، إلى قواطع الأدلة، في أصول الاعتقاد، إملاء الشيخ الإمام ركن الإسلام: «أبي المعالي عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف الجويني» رضي اللّه عنه.
ص: 333
ص: 334
الصورة

ص: 335
الصورة
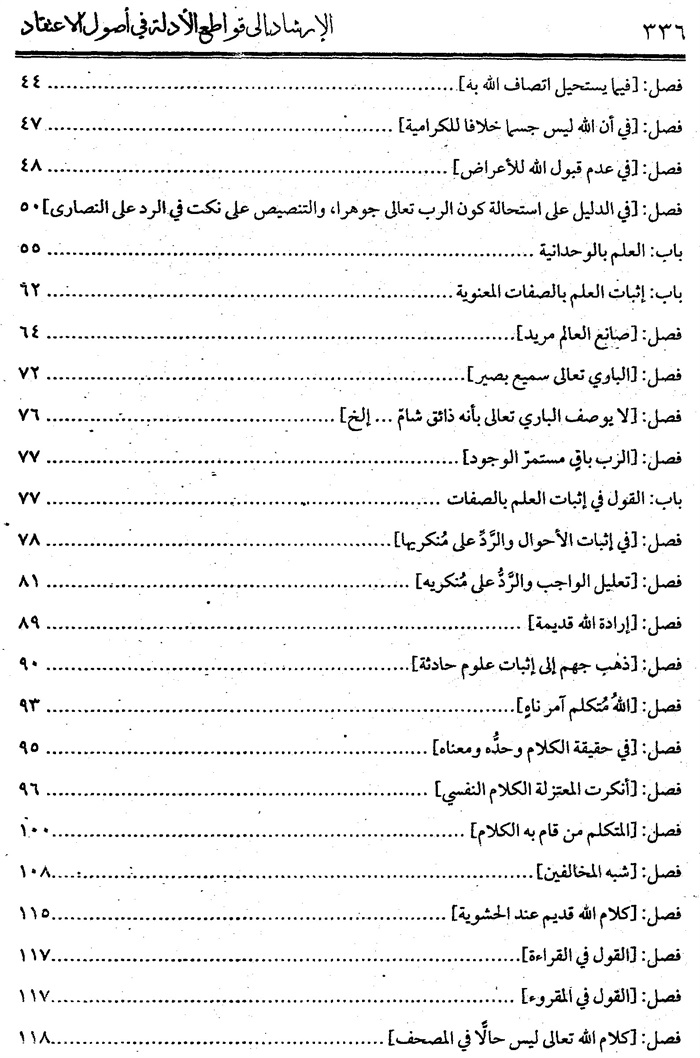
ص: 336
الصورة

ص: 337
الصورة

ص: 338
الصورة

ص: 339
الصورة

ص: 340
الصورة
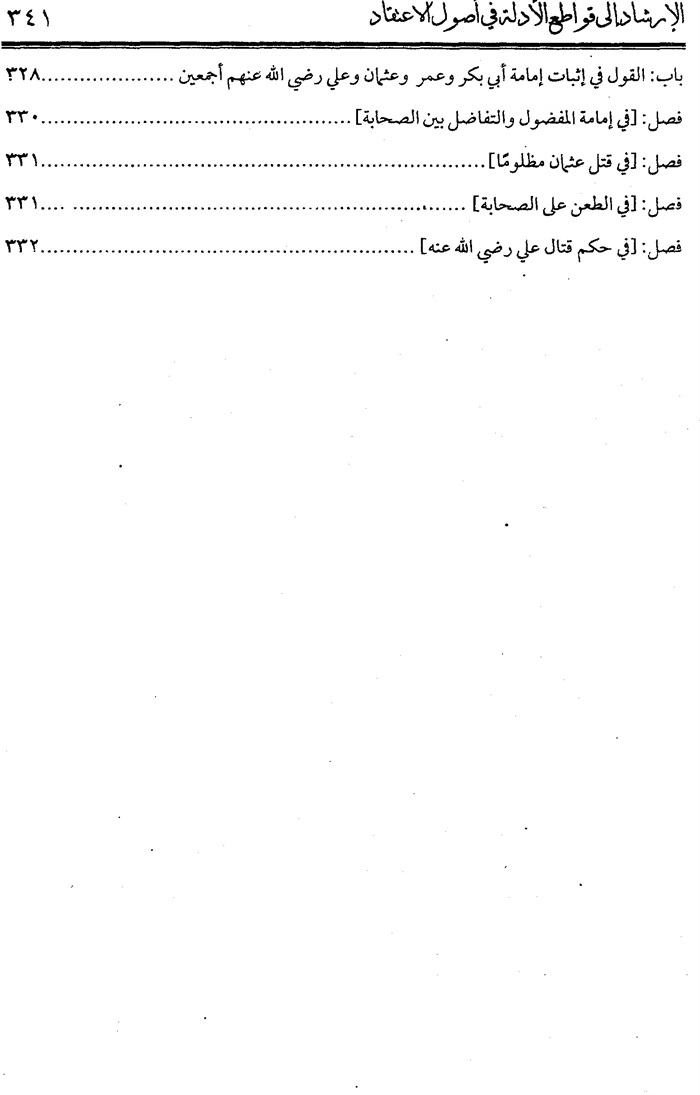
ص: 341