الفهارس العامّة
اشارة
الصورة
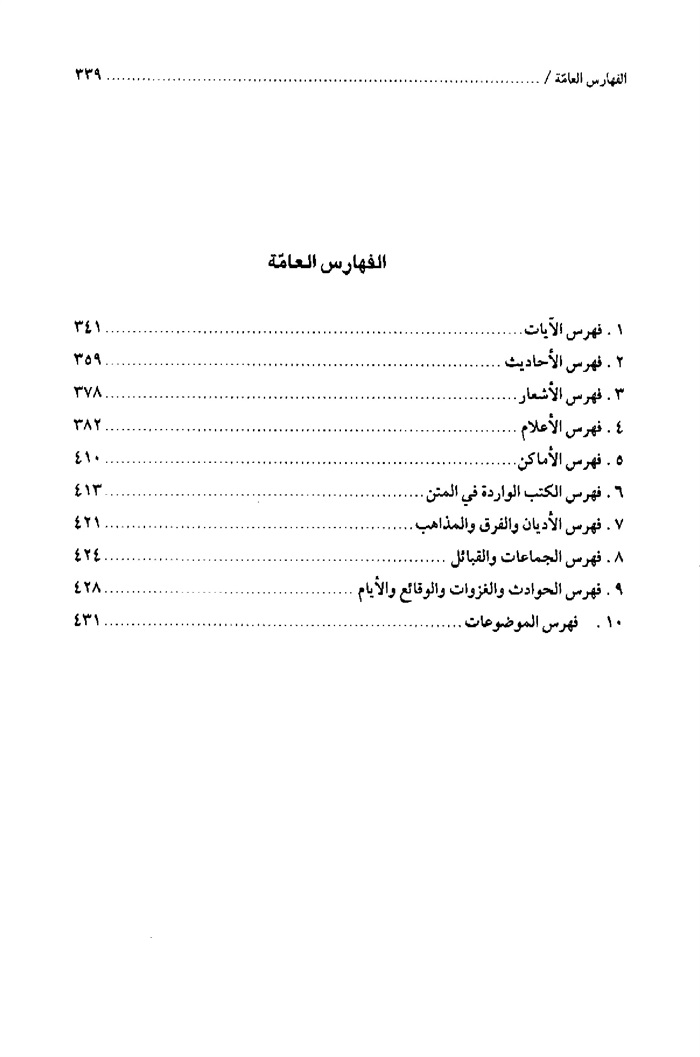
ص: 339
بطاقة تعريف: کنگره بین المللی بزرگداشت ثقةالاسلام کلینی(ره) (1388 : شهرری)
عنوان المؤلف واسمه: مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني/ ویراستار حسین پورشریف.
تفاصيل النشر: قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر: سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 1387.
مشخصات ظاهری : 5ج.
فروست : پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛ 192.
مجموعه آثار کنگره بین المللی بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی؛ 40، 41، 42، 43، 44.
شابک : 64000 ریال
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج.1. مباحث کلی.- ج.2. مباحث کلی.- ج.3. مصادر و اسناد کافی.- ج.4. مباحث فقه الحدیثی.- ج.5. مباحث فقه الحدیثی.
موضوع : کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. -- کنگره ها
موضوع : کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. -- نقد و تفسیر
موضوع : کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. . الکافی -- نقد و تفسیر
موضوع : محدثان شیعه -- ایران -- کنگره ها
معرف المضافة: پورشریف، حسین، 1354 -، ویراستار
تصنيف الكونجرس: BP129 /ک8ک2057 1388
تصنيف ديوي: 297/212
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 8 8 5 5 3 6
مذكّرة أمين اللجنة العلمية للمؤمر
كتاب الكافي الشريف، لمؤّفه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، هو أهم وأفضل مؤلّفات الشيعة، ونظرا لما يتمتّع به من ميزات وخصائص جعلت منه كتابا لا نظير له، فقد صار محوراً لظهور وإنتاج قسم واسع من التراث الشيعي، وحظي على مرّ التاريخ باهتمام علماء الشيعة وقدّمت له شروح وتعليقات وترجمات كثيرة.
وقد قامت روضة السيّد عبدالعظيم الحسني ومؤسة دار الحديث العلمية الثقافية بعقد المؤتمر الثالث من مؤتمراتها التي تدور حول محور «تكريم شخصيات مدينة الري وعلمائها» لتكريم ثقة الإسلام الكليني.
والأهداف المتوخّاة من هذا التكريم هي:
1 . التعريف بالشخصية العلمية والمعنوية لثقة الإسلام الكليني.
2. نشر المعارف الحديثية لأهل البيت عليهم السلام.
3. تحقيق ودراسة تراث ثقة الإسلام الكليني.
4. معرفة منزلة وتأثير كتاب الكافي.
وقد بدأت لجنة المؤمر العلمية التخطيطَ العملي لهذا المؤمر بعد إقامة مؤمر تكريم أبي الفتوح الرازي في خريف 1427ق، وخطّطت للبرامج التالية:
1 . تصحيح وتحقيق المخطوطات المتعلّقة بكتاب الكافي، سواء كانت ترجمات أو شروح أو تعليقات أو غيرها.
2. فتح آفاق بحثية جديدة في مجال الكافي.
3. تجزئة وتحليل الانتقادات والأسئلة المتعلّقة بالكافي.
4. تقديم الطبعة المحقّقة من كتاب الكافي.
5. تنظيم المعلومات والآثار المكتوبة المتعلقة بالكليني والكافي وتقديمها في قالب أقراص DVD (الأقراص النورية المتعدّدة الأغراض).
والذي توصّلت إليه اللجنة العلمية خلال سنتين ونيف من السعي هو نشر ما يلي تزامناً مع إقامة المؤمر:
ص: 1
أولاً: نسخة الكافي المحقّقة.
ثانياً: شروح الكافي والتعليقات عليه.
ثالثاً: مجموعة الآثار التي أنتجها المؤمر.
رابعاً: الأعداد الخاصّة من المجلاّت.
خامساً: نشرة أخبار المؤمر.
سادساً: أقراص ال-DVD (الأقراص النورية المتعدّدة الأغراض).
وسنلقي فيما يلي نظرة عابرة إلى هذه العناوين الستّة:
أولاً: الكافي
سيتمّ طبع الكافي طبعة جديدة بعد مقابلته مع المخطوطات القديمة والموثوق بها وبعد التشكيل بالحركات أيضاً، مع تعليقات بهدف رفع الإشكال عن بعض الإسنادات، وبعض الإيضاحات ذات
العلاقة بفقه الحديث.
ثانياً: شروح الكافي وتعليقاته
كتب الكثير من الشروح والتعليقات على كتاب الكافي ولم يطبع منها سوى القليل، وقد سعت اللجنة العلمية لأن تحدّد هذه الشروح والتعليقات، وأن تأخذ على عاتقها تحقيقها وعرضها، وسيتمّ تحقيق الكتب التالية وطباعتها وإعدادها لإقامة المؤمر:
1. الشافي في شرح الكافي، الملاّ خليل بن غازي القزويني، (ت 1089ق) مجلّدان.
2. صافى در شرح كافى (الصافي في شرح الكافي) الملاّ خليل بن غازي القزويني (ت 1089ق) مجلّدان.
3. الحاشية على اُصول الكافي، الملاّ محمد أمين الاسترآبادي (ت 1036ق) مجلّد واحد.
4. الحاشية على اُصول الكافي، السيّد أحمد العلوي العاملي (كان حيّا سنة 1050ق) مجلّد واحد.
5. الحاشية على اُصول الكافي، السيّد بدر الدين الحسيني العاملي (كان حيّا سنة 1060ق) مجلّد واحد.
6. الكشف الوافي في شرح اُصول الكافي، محمد هادي بن محمد معين الدين آصف الشيرازي (ت 1081ق) مجلّد واحد.
7. الحاشية على اُصول الكافي، الميرزا رفيعا (ت 1082ق) مجلّد واحد.
8. الهدايا لشيعة أئمة الهدى (شرح اُصول الكافي) ، الميرزا محمّد مجذوب التبريزي (ت 1093 ق) مجلّدان.
ص: 2
9. الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح اُصول الكافي) ، رفيع الدين محمد بن محمد مؤن الگيلاني (القرن 11ق) مجلّدان
10 و 11. الدرّ المنظوم، الشيخ علي الكبير (ت 1104ق) والحاشية على اُصول الكافي، الشيخ علي الصغير (القرن 12ق) مجلّد واحد.
12. تحفة الأولياء (ترجمة اُصول الكافي) ، محمد علي بن محمد حسن الفاضل النحوي الأردكاني (كان
حياً في 1237ق) 4 مجلّدات.
13. شرح فروع الكافي، محمد هادي بن محمد صالح المازندراني (ت 1120ق) 5 مجلّدات.
14. البضاعة المزجاة (شرح روضة الكافي) ، محمد حسين بن القارياغدي (ت 1089ق) مجلّدان.
15. منهج اليقين (شرح وصية الإمام الصادق للشيعة) ، السيّد علاء الدين محمد گلستانة (ت 1110ق) مجلّد واحد.
16. مجموعة الرسائل في شرح أحاديث الكافي، مجلّدان.
ثالثاً: مجموعة الآثار التي أنتجها المؤمر
المراد من هذا العنوان الآثار التي أنتجتها اللجنة العلمية، وسيتمّ تقديم الآثار التالية في هذا المجال:
1. حياة الشيخ الكليني، ثامر العميدي، مجلّد واحد.
2. توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة أسناد الكافي ، السيّد محمد جواد الشبيري ، مجلّدان .
3. العنعنة من صيغ الأداء للحديث الشريف في الكافي، السيّد محمد رضا الحسيني الجلالي، مجلّد واحد.
4. كافى پژوهى در عرصه نسخه هاى خطى (دراسات في الكافي وفق النسخ الخطيّة) ، علي صدرائي الخوئي، السيّد صادق الأشكوري، مجلّد واحد.
5. كتاب شناسى كلينى و كتاب الكافي (ببلوغرافيا الكليني وكتابه الكافي) ، محمد قنبري ،
مجلّد واحد .
6. شناخت نامه كلينى والكافي (معلومات متناثرة حول الكليني والكافي) ، محمد قنبري ،
4 مجلّدات .
7. كافى پژوهى (تقرير عن الأطروحات ورسائل التخرج المتعلقة بالكليني والكافي) ، السيّد محمد
علي أيازي، مجلّد واحد.
8 . مجموعه مقالات همايش (مجموعة مقالات المؤتمر) مجموعة من الباحثين، 7 مجلّدات.
9 . مصاحبه ها و ميزگردها (الحوارات) ، مجلّد واحد.
ص: 3
رابعاً: الأعداد الخاصة من المجلاّت
سوف تصدر كلّ من مجلّة آينه پژوهش، سفينه، علوم الحديث والبعض الآخر من النشريات، أعداداً خاصة تزامناً مع إقامة المؤمر.
خامسا: نشرة أخبار المؤتمر
سيتمّ طبع أربعة أعداد من نشرة أخبار المؤمر التي تقوم بمهمّة الإعلام قبل المؤمر حتى زمان انعقاده.
سادساً. أقراص ال- DVD
سوف يتمّ تقديم البرنامج الألكتروني لمجموعة آثار المؤمر، مع بعض مخطوطات الكافي، وكذلك الشروح والتعليقات والترجمات المطبوعة لكتاب الكافي في قالب أقراص DVD.
مجموعة المقالات العربية
إحدى نتائج المؤتمر العلمية هو تدوين المقالات المفيدة باللغة العربية عن الكليني والكافي .
وبعد الإعلان العام وصلت مقالات كثيرة للأمانة العامة للمؤتمر . وبعد التقييم العلمي انتخبت 22 مقالة ، واعدت للنشر في مجموعة مقالات المؤتمر . وقد نشرت هذه المقالات في مجلدين .
1 - المجلّد الأول : ويضم 13 مقالة ؛
2 - المجلّد الثاني : ويضم 9 مقالات .
والجدير بالذكر إنّ المقالات الفارسية قد طبعت في خمسة مجلدات .
وفي الختام نقدم شكرنا إلى جميع المثقّفين والمفكّرين، والمنظّمات والمؤّسات العلمية البحثية، التي أسهمت في تحقيق النتائج المرجوّة من هذا المؤتمر، خاصة: سادن روضة السيّد عبدالعظيم عليه السلام
ورئيس مؤسة دار الحديث العلمية الثقافية، سماحة آية اللّه محمد الرَّيشَهري، اللجنة العليا لتعيين أهداف المؤمر، اللجنة العلمية للمؤمر، لجنة العلاقات الدولية، اللجنة التنفيذية، مؤسة البحوث الإسلامية التابعة للروضة الرضوية المقدسة، مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية، المدراء العامّين في روضة السيّد عبد العظيم عليه السلام، المدراء والباحثين في مؤسسة علوم الحديث ومعارفه، المسؤولين، الأساتذة والطلاب في كلية علوم الحديث، المسؤلين والعاملين في دار النشر التابعة لدار الحديث.
مهدي المهريزي
الأمين العام للجنة العلمية
1429 ق
ص: 4
مذكّرة أمين اللجنة العلمية للمؤتمر.......... 3
حياة الشيخ الكليني.......... 7
السيّد ثامر العميدي
المحدّث الكليني وأثره الخالد.......... 87
الشيخ جعفر السبحاني
منهجية الكليني في الكافي.......... 101
علي محمود البعاج
عِدّاتُ الكليني ومشايخه.......... 127
الشيخ طه الكافي / بمساعدة السيّد مجتبى صحفي
الراويات النساء من كتاب الكافي للكليني.......... 195
سلمى حسين علوان الموسوي
إحداثيات الفكر الاثني عشري بين الكليني والصدوق ، دراسة فلسفية - كلامية.......... 221
د. علي حسين الجابري
نظرية المعرفة عند الإمامية ، مرويات الكافي مستندا.......... 243
د . عبد الأمير كاظم زاهد
القرآن الكريم كما تصوّره روايات أُصول الكافي.......... 263
الشيخ محمّد علي التسخيري
ص: 1
موقف الكليني من القول بتحريف القرآن في كتاب الكافي.......... 273
د . مديحة خضير كاظم
«صيانة القرآن» بين الخفاء والجلاء.......... 297
حيدر المسجدي
منهج تفسير القرآن بالقرآن في مرويات الكافي للشيخ الكليني.......... 367
د . سيروان عبد الزهرة هاشم
الأثر التفسيري في روايات «الكافي» ، كتاب الزكاة أُنموذجا.......... 407
عدي جواد الحجّار
إشارات إلى تفسير الإمام الصادق عليه السلام في أُصول الكافي ، قراءة تحليلية موازنة.......... 435
د . حميد الفتلي
ص: 2
سخن دبير كنگره
ص: 3
سخن دبير كنگره
ص: 4
سخن دبير كنگره
ص: 5
سخن دبير كنگره
ص: 6
حياة الشيخ الكليني
السيّد ثامر العميدي(1)
عاش الكليني قدس سره في حقبة حاسمة من تاريخ العصر العبّاسي الثاني (232 - 334 ه ) امتدّت من أوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وحتّى نهاية الربع الأوّل من القرن الرابع الهجري وزاد عليها بقليل؛ وذلك في مكانين مختلفين، أوّلهما: موطنه الأساس (الريّ)، وثانيهما: عاصمة الدولة العبّاسية (بغداد)، حيث أقام بها زهاء عشرين سنة، الأمر الذي يعني ضرورة تسليط الضوء على أهمّ الجوانب السياسية والفكرية في هاتين الحاضرتين دون غيرهما من الحواضر العلمية الأُخرى المنتشرة في ذلك الزمان والتي وصل الكليني إلى بعضها، ونقل الحديث عن جملة من مشايخها.
وإذا ما علمنا أنّ الكليني قدس سره قد عاش ثلثي عمره تقريبا في الريّ، والثلث الأخير في بغداد، وعلمنا أيضا موقع الريّ الريادي في المشرق الإسلامي يومذاك، وموقع بغداد بالذات، وثقلها السياسي والفكري كعاصمة للدولة، اتّضح أنّ الحديث عنهما بأيّ صعيد كان، هو الحديث عن غيرهما بذلك الصعيد نفسه، ووجود بعض الفوارق الطفيفة لا يبرّر تناولها في عصره السياسي والفكري، سيّما بعد حصر منابع ثقافته
ص: 7
وتطلّعاته في موطنه ومكان إقامته، وانطلاق شهرته إلى العالم الإسلامي منهما لا غير.
وبما أنّ الحياة السياسية والفكرية لأي عصر مرتبطة بماضيها، فسيكون طرح مرتكزاتها من الحسابات الفكرية وإهمال جذورها التاريخيّة وخيما على نتائج دراساتها، ما لم يتمّ الكشف فيها عن نوع ذلك الارتباط، وهو ما لوحظ باختصار في دراسة عصر الكليني سياسيا وفكريا في مبحثين:
تُعدّ الريّ من أوّل المدن التي بُنيت في زمان الأكاسرة بعد مدينة جيومَرْت. ولمّا طال عليها الأمد جدّد بناءها الملك فيروز، وسمّاها (رام فيروز)(1)، ولكنّها تعرّضت - بعد الفتح الإسلامي - للهدم والبناء والتجديد.
ومن المعارك الحاسمة في تاريخها قبل الفتح الإسلامي المعركة التي دارت بين ولدي يزدجرد بالريّ: فيروز وهرمز(2). وتعرّضت لأوّل غزو من العرب قبل الإسلام على يد عمرو بن معديكرب، ثمّ انصرف منها ومات في كرمنشاه(3).
هذا قبل فتحها إسلاميا، وأمّا بعد فتحها فقد اختلف المؤرّخون في تاريخ دخول الإسلام بلاد الريّ، تبعا لاختلافهم في تاريخ فتحها. والمتحصّل من جميع الأقوال أنّ تاريخ فتح الريّ مردّد ما بين الفترة من سنة ثمان عشرة وحتّى سنة ثلاث وعشرين.
وقد شهد قاضي الريّ يحيى بن الضرّيس بن يسار البجلي أبو زكريا الرازي (ت / 203 ه ) على انتفاض الري في زماني عمر وعثمان مرات عديدة(4). ولا شكّ أنّ انتفاضها وتمرّد أهلها خمس مرّات متعاقبة في أقلّ من عشر سنين! يشير بوضوح
ص: 8
إلى سوء تصرّف الفاتحين، كتخريبهم المدينة وهدمها. ولعلّ ما قام به أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذه الحقيقة، إذ أوقف زحف الجيوش الإسلامية ريثما يستتبّ إصلاح الأُمّة من الداخل.
ولم يُؤْثَر عن أهل الريّ طيلة مدّة خلافة أمير المؤمنين الفعلية وخلافة الحسن السبط عليهماالسلام أي انفصال أو انتفاض أو تمرّد يذكر، بخلاف ما كان عليه حالهم في زماني عمر وعثمان.
وحينما ظهرت دولة الطلقاء من بني أُمية امتدّ نفوذها إلى الريّ، وَوَلِيَها لمعاوية كثير بن شهاب الحارثي(1).
ومن الحوادث السياسية المهمّة التي شهدتها الري في أوائل حكم الأمويين قوّة الخوارج المتنامية، حيث اتّخذها من أرتثّ من الخوارج يوم النهروان موطنا كحيّان بن ظبيان السلمي وجماعته، الذين شكّلوا فيما بعد حزبا سياسيّا قويّا تبادل النصر والهزيمة في معارك طاحنة مع الأمويين.
كما تعرّضت الري في أواخر العهد الأموي إلى ثورات الطالبيين، فظهر عليها سنة (127 ه ) عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب وسيطر عليها(2).
وكان آخر ولاة الأمويين على الريّ حبيب بن بديل النهشلي الذي خرج من الري ومن معه من أهل الشام خشية من جيوش العبّاسيين بقيادة الحسن بن قحطبة بن شبيب.
وانتهت فترة حكم الأمويين على بلاد الري قبل قيام الدولة العبّاسية بسنة واحدة، ولم يكن حال الري سياسيا في ظلّ الدولة العبّاسية التي نشأت سنة (132 ه ) بأحسن ممّا كانت عليه في دوله الأمويين؛ إذ سرعان ما انفصلت الري عن دولتهم بعيد
ص: 9
نشأتها، وذلك بعد قيام المنصور العبّاسي بقتل داعية العبّاسيين أبي مسلم الخراساني سنة (137 ه ).
ثمّ نالت الريّ بعد ذلك اهتمام بني العبّاس ورعايتهم، نظرا لموقعها الجغرافي المميّز.
ولتعسّف السلطة العبّاسية، تفجّرت الثورات العلوية في أماكن شتّى، واستجاب أهل الري لتلك الثورات، وأسهموا فيها بشكل كبير. فأنشأ الحسن بن زيد العلوي الدولة العلوية في طبرستان في زمان المستعين (248 - 252 ه )، وسرعان ما امتدّ نفوذها إلى الري. ولم يدم الأمر هكذا، إذ تمكن قوّاد المعتزّ (252 - 255 ه-) من الترك في أواخر عهده من السيطرة على الري في سنة (255 ه ). وخضعت الري إلى سلطة الأتراك وتعاقب ولاتهم عليها.
ولم يلبث حال الري عرضة للأطراف المتنازعة عليها إلى أن تمكّن أبو علي ابن محمّد بن المظفّر صاحب جيوش خراسان للسامانيين من دخول الري سنة (329 ه ). ولم يستتب أمر الري بيد البويهيين ، إذ نازعهم عليها الخراسانيون من السامانيين، إلى أن تمكّن البويهيون بقيادة ركن الدولة البويهي من الري فانتزعوها من أيدي السامانيين في سنة (335 ه )(1)، أي بعد ستّ سنين على وفاة ثقة الإسلام الكليني ببغداد.
وبهذا نكون قد توفّرنا على الإطار السياسي الواضح الذي كان يلفّ الري منذ فتحها الإسلامي وإلى نهاية عصر الكليني الذي احتضن ثقة الإسلام زمانا ومكانا.
امتازت الري عن غيرها من بلاد فارس بموقعها الجغرافي، وأهميّتها الاقتصادية، فهي كثيرة الخيرات وافرة الغلاّت، عذبة الماء، نقيّة الهواء، مع بعدها عن مركز الخلافة
ص: 10
العبّاسية ببغداد، زيادة على كونها بوّابة للشرق في حركات الفتح الإسلامي، ومتجرا مهمّا في ذلك الحين.
ولشهرة الري وموقعها، قصدها بعض الصحابة(1)، وكبار التابعين وتابعيهم، كسعيد بن جبير، حيث كانت له رحلة شملت مدينة الري، والتقى به الضحّاك (ت 105 ه ) وكتب عنه التفسير في الري(2). ووصل الشعبي (ت 103 ه ) إلى الري ليدخل على الحجّاج يوم كان عاملاً لطاغية عصره عبدالملك بن مروان علي الري(3). كما دخلها سفيان الثوري (ت 161 ه )(4).
ومات في الري الكثير من الأعلام والفقهاء والمحدّثين والأدباء والشعراء والقوّاد، كمحمّد بن الحسن الشيباني، والكسائي النحوي، والحجّاج بن أرطاة، وغيرهم. وكان للشعراء والأُدباء حضور بارز في تلك المدينة.
ضمّت الري في تاريخها الإسلامي خليطا من المذاهب والفرق والتيّارات الفكرية المتعدّدة، وكانت جذور هذا الخليط الواسع ممتدّة في تاريخ الري، ممّا نجم عن ذلك ثقل ما وصل إلى زمان الكليني رحمه الله من التراث بكلّ مخلّفاته، والذي ابتعد في كثير منه عن الإسلام روحا ومعنىً، ومعرفة كلّ هذا يفسّر لنا سبب طول الزمان الذي استغرقه ثقة الإسلام في تأليف الكافي الذي تقصّى فيه الحقائق، ودرس الآراء السائدة في مجتمعه، واستوعب اتّجاهاتها، ومحّصها بدقّة، حتّى جاء بالإجابة الشافية على جميع ما كان يحمله تراث الري من تساؤلات.
وفيما يأتي استعراض سريع لما شهدته الري من مذاهب وفرق وآراء، وهي:
ص: 11
كان الطابع العامّ لمجتمع الري بعد فتحها الإسلامي، هو الدخول التدريجي في الدين الجديد بمعناه الإسلامي العريض؛ إذ لم تكن هناك مذاهب وفرق، وإنّما انحصر الأمر في اعتناق الإسلام بإعلان الشهادتين، ولا يمنع هذا من الميل إلى بعض الاتّجاهات الفكرية المتطرّفة. ولا غرابة في ذلك؛ لأنّ قرب العهد بالدين الجديد مع اختلاط أوراقه بين نظريتين، جعل إسلام الرازيين - في ذلك الحين - غضّا طريا قابلاً لأن يتأثّر بأيّ اتجاه ويصطبغ بلونه، ومن هنا كانت لبقيّة الخوارج الذين ارتثوا في معركة النهروان صوت يسمع في بلاد الري، حيث اتّخذوها موطناً، ومنها خرجت أنصارهم في معاركهم العديدة مع الأمويين.
انتقل النصب - وهو عداوة أهل البيت عليهم السلام - إلى الريّ منذ إن وطأت أقدام الأمويين السلطة بعد صلح الإمام الحسن السبط عليه السلام سنة (41 ه )، حيث سنّ معاوية بدعته في سبّ أمير المؤمنين عليه السلام على منابر المسلمين، وكان منبر الري واحدا منها!
ولا شكّ في أنّ بقاء بدعة سب الوصي عليه السلام زهاء ستّين عاما كافية لأنّ تنشأ عليها أجيال لا تعرف من إسلامها شيئا إلاّ من عصم اللّه.
ونتيجة لوجود الهوى الأموي السفياني بين أهل الري، فقد انتشرت في أوساطهم عقيدة الإرجاء واستمرّ وجودها إلى زمان ثقة الإسلام الكليني، تلك العقيدة الخبيثة التي شجّعتها الأموية لتكون غطاء شرعيّا لعبثها في السلطة، ومبرّرا لاستهتارها بمقدّرات الأمّة.
تأثّرت الري كغيرها من مدن الإسلام بآراء المدرستين الآتيتين، وهما:
ص: 12
1 - المدرسة السلفية، وهي المدرسة التي كانت تهدف إلى إحياء المفاهيم السلفية الموروثة عن السلف وتحكيمها في مناحي الحياة، ورفض المناظرة والجدل، ويمثّل هذه المدرسة الفقهاء والمحدّثون من العامّة، وقد بسطت هذه المدرسة نفوذها على مجمل الحركة الفكرية في بلاد الإسلام، إلاّ في فترات محصورة ومحدودة ترجّحت فيها كفة المدرسة الثانية.
2 - المدرسة العقلية، وهي المدرسة التي استخدمت المنهج العقلي في فهم وتحليل جملة من النصوص التي تستدعي التوفيق بين أحكام الشرع وأحكام العقل، وكان روّاد هذه المدرسة الشيعة والمعتزلة، حيث اعتمدوا المنهج العقلي في تفسير ما لم يرد فيه أثر صحيح.
وكان الصراع بين المدرستين يشتدّ تارة ويخفّ أو يتلاشى أُخرى، بحسب مواقف السلطة ومبتنياتها الفكرية، ولهذا نجد انتعاش المدرسة العقلية في عهد المأمون (198 - 218 ه ) ؛ لميله إليها، وحتّى عهد الواثق (227 - 232 ه )، ولمّا جاء المتوكّل (232 - 247 ه ) أظهر ميله إلى المدرسة السلفية، وأرغم الناس على التسليم والتقليد، ونهاهم عن المناظرة والجدل ، وعمّم ذلك علي جميع بلاد الإسلام(1). وسار على نهجه المعتمد والمعتضد(2).
وممّن عرف من رجال المدرسة السلفية في بلاد الري، الفضل بن غانم الخزاعي. ومن أنصار المعتزلة في الري قاضيها جعفر بن عيسى بن عبداللّه بن الحسن بن أبي الحسن البصري (ت 219 ه )، حيث كان يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن أيّام المحنة ببغداد.
كان للزيديّة وجود في بلاد الري، ويدلّ عليه دخول جماعة من أهل الري على
ص: 13
الإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام ببغداد، وكان فيهم رجل زيدي وجماعته لا يعلمون مذهبه، فكشف لهم الإمام عليه السلام عن مذهبه(1)، ومن المستبعد أن يكون هو الزيدي الوحيد في تلك البلاد، كما أنّ في قادة الدولة العلوية في طبرستان من أعلام الزيديّة الكثير.
وهم أتباع الحسين بن محمّد النجّار ، وقد افترقت بناحية الري إلى فرق كثيرة يكفّر بعضها بعضا(2)، وقد عدّ المصنّفون في المقالات فرق النجّارية من الجبرية(3) في حين أنّهم وافقوا المعتزلة في كثير من المسائل.
وذكر الاسفراييني أنّ فرق النجارية في الري أكثر من عشر فرق ، إلاّ أنّه اكتفى بذكر أشهرها، ومثله فعل الشهرستاني في الملل، إذ ذكرا ثلاث فرق فقط هي : البرغوثية ، والزعفرانية ، والمستدركة.
انحصر وجود المذاهب العامّية بالري في مذهبين، وهما: المذهب الحنفي، والشافعي. وأمّا المذهب المالكي فقد كان امتداده في المغرب الإسلامي بفضل تلامذة مالك بن أنس، ولم يمتدّ إلى المشرق الإسلامي كثيرا، وأمّا عن مذهب أحمد بن حنبل، فهو أقلّ المذاهب الأربعة أتباعا، وآخرها نشأة، ولم تكن له تلك القدرة العلمية الكافية التي تسمح له بالامتداد خارج محيطه بغداد في عصر نشأته، سيّما وأن أحمد بن حنبل لم يكن فقيها، بل كان محدّثا؛ ولهذا أهمله الطبري - المعاصر لثقة الإسلام الكليني - في كتابه الشهير اختلاف الفقهاء. الأمر الذي يفسّر لنا عدم امتداد
ص: 14
فكر أتباعه في عصر الكليني إلى الريّ على الرغم من وقوف السلطة العبّاسية إلى جانب الحنابلة بكلّ قوة.
ومهما يكن فإنّ أغلب أهل الري كانوا من الحنفية والشافعية، وأكثرهم من الأحناف، كما صرّح به الحموي(1). ثم انحسر الوجود العامّي في الري بعد سنة (275 ه ).
ونتيجة لهذا الخليط الواسع في الري، من نواصب وزيدية ومعتزلة وجبرية وأحناف وشافعية، فقد ظهر الكذّابون والمتروكون في تلك البلاد. كما كثر المنجّمون في تلك البلاد بصورة واسعة.
إنّ اتّفاق جميع من كتب في المقالات والفرق على أسبقيّة التشيّع على سائر المذاهب والفرق التي نشأت في الإسلام، لهو دليل كافٍ على صدق ما تدّعيه الشيعة من عراقة مذهبها، وكونه المعبّر الواقعي عن مضمون رسالة الإسلام، ومن هنا حمل التشيّع عناصر البقاء وأسباب الخلود على رغم العواصف العاتية التي وقفت حائلاً بوجه امتداده.
وهكذا كان للضغط السياسي المتواصل على الشيعة دورا في امتداد التشّيع خارج رقعته الجغرافية، بحيث استطاع في الشرق أنّ يمصِّرَ مدنا ويبني دولة في الطالقان، وأن يؤسّس في الغرب الإسلامي دولة كبرى لا زال أزهر مصر يشهد على فضلها وآثارها.
وبعد هذه المقدّمة الخاطفة لنرى كيف استطاع التشيّع أن يشقّ طريقه إلى الري بعد أن عرفنا نصبها وعداوتها لأهل البيت عليهم السلام، فضلاً عمّا كان فيها من اتّجاهات مذهبية وطوائف مختلفة، مضافاً لموقف السلطة المساند لهذا الاتّجاه أو ذاك ما خلا
ص: 15
الشيعة؟
كانت الصفة الغالبة على أهل الري قبل عصر الكليني هي الأموية السفيانية الناصبة، مع تفشّي الآراء المتطرّفة والأفكار المنحرفة، والفرق الكثيرة التي لا تدين بمذهب آل محمّد صلى الله عليه و آله . لكن لم يعدم الوجود الشيعي في الري، وإنّما كان هناك بعض الشيعة من الرازيين الذين اعتنقوا التشيّع تأثّرا بمبادئه، وساعدهم على ذلك وجود بعض الموالي الشيعة من الفرس في الكوفة في زمان أمير المؤمنين عليه السلام ، مضافاً لمن سكن الري من شيعة العراق، ومن استوطنها من أبناء وأحفاد أهل البيت عليهم السلامالذين جاؤوها هربا من تعسّف السلطات. ويظهر من خلال بعض النصوص أنّ الشيعة فيها كانوا في تقيّة تامّة، حتّى بلغ الأمر أنّ السيد الجليل عبدالعظيم الحسني الذي سكن الري وكان من أجلاّء أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهماالسلام ، لم يعرفه أحد من شيعة الري إلى حين وفاته، حيث وجدوا في جيبه - وهو على المغتسل - رقعة يذكر فيها اسمه ونسبه!
امتاز العصر العبّاسي الأوّل (132 - 232 ه ) بسيطرة العبّاسيين على زمام الأُمور سيطرة محكمة، وإدارة شؤون الدولة بحزم وقوّة، بخلاف العصر العبّاسي الثاني الذي ابتدأ بمجيء المتوكّل إلى السلطة وانتهى بدخول البويهيين إلى بغداد سنة (344 ه ) حيث تدهورت فيه الأوضاع السياسية كثيرا لاسيّما في الفترة الأخيرة منه، وهي التي عاشها الكليني ببغداد، فلابدّ من إعطاء صورة واضحة للمؤثّرات السياسية والفكرية التي أسهمت في تكوين رؤية الكليني للمجتمع الجديد وتساؤلاته التي حاول الإجابة عليها في كتابه الكافي، فنقول:
يرجع تدهور الحياة السياسية ببغداد في عصر الكليني إلى أسباب كثيرة أدّت إلى
ص: 16
سقوط هيبة الدولة من أعين الناس، إليك أهمّها :
وهو نظام سياسي عقيم، وخلاصته: أن يعهد (الخليفة) بالخلافة لمن يأتي بعده مع أخذ البيعة له من الأُمّة كرها في حياته، وهو بهذه الصورة يمثّل قمّة الاستبداد وإلغاء دور الأُمّة وغمط الحقوق السياسية لجميع أفرادها .
وممّا زاد الطين بلّة إعطاء ولاية العهد لثلاثة، وهو ما فعله المتوكّل الذي قسّم الدولة على ثلاثة من أولاده، وهم: المنتصر، والمعتزّ، والمؤيّد(1)، ممّا فسح - بهذا - المجال أمامهم للتنافس ومحاولة كلّ واحد عزل الآخر من خلال جمع الأعوان والأنصار، بحيث أدّى ذلك في بعض الأحيان إلى معارك طاحنة كما حصل بين الأمين والمأمون.
وانتهى هذا النظام بعد قتل المتوكّل، إلاّ أنّ البديل كان أشدّ عقما؛ إذ صار أمر تعيين (الخليفة) منوطا بيد الأتراك، مع التزامهم بعدم خروج السلطة عن سلالة العبّاسيين .
مما أدّى إلى تفاقم الأوضاع في هذا العصر، انشغال الخلفاء العبّاسيين بالعبث واللهو، إلى حدّ الاستهتار بارتكاب المحرّمات علنا بلا حريجة من دين أو واعز من ضمير.
وقد عُرِفَ عبثهم ومجونهم منذ عصرهم الأوّل، فالمنصور العبّاسي (136 - 158 ه-) مثلاً كان في معاقرته الخمر يحتجب عن ندمائه؛ صونا لمركزه، في حين أعلن ولده المهدي (158 - 169 ه-) ذلك، وأبى الاحتجاب عن الندماء.
وقد بلغ الأمر في العصر العبّاسي الأوّل أن ظهر من البيت الحاكم نفسه رجال ونساء عرفوا بالخلاعة والمجون والطرب والغناء. حتّى إذا ما أشرف عصرهم الأوّل على نهايته بالواثق تفشّى الغناء والطرب والمجون بين أرباب الدولة.
ص: 17
من آفات هذا العصر التي أدّت إلى انتكاسات سياسية خطيرة، مجيء الصبيان إلى السلطة ، حتّى صاروا ألعوبة بيد النساء والأتراك والوزراء والجند وغيرهم من رجال الدولة، نظير المقتدر باللّه (295 - 320 ه ) الذي كان عمره يوم وُلي الخلافة ثلاث عشرة سنة(1)؛ ولهذا استصباه الوزير العبّاس بن الحسن، حتّى صار ألعوبة بيده. وكان صبيّا سفيها، فرّق خزينة الدولة على حظاياه وأصحابه حتّى أنفدها(2).
يرجع تاريخ تدخّل النساء في شؤون الدولة العبّاسية إلى عصرها الأوّل، وتحديدا إلى زمان الخيزران زوجة المهدي العبّاسي التي تدخّلت في شؤون دولته، واستولت على زمام الأُمور في عهد ابنه الهادي (169 - 170 ه )(3)، وكذلك في هذا العصر حيث تدخّلت قبيحة أمّ المعتزّ في شؤون الدولة(4).
واستفحل أمر النساء والخدم في عهد المقتدر ، قال ابن الطقطقي:
كانت دولته تدور أمورها على تدبير النساء والخدم، وهو مشغول بلذّته، فخربت
الدنيا في أيّامه، وخلت بيوت الأموال(5).
وذكر مسكويه ما كان لقهرمانات البلاط العبّاسي من دور كبير في رسم سياسة الدولة(6).
من الأُمور البارزة في تاريخ هذا العصر، ظهور العنصر التركي وسيطرته على مقاليد
ص: 18
الأُمور، الأمر الذي يعبّر لنا عن ضعف السلطة المركزية وتدهورها؛ لانشغالهم بلهوهم ومجونهم، مما تسبّب في سيطرة الأتراك على الدولة وتدخّلهم المباشر في رسم سياستها، ويرجع تاريخ تدخّلهم في ذلك إلى عهد المعتصم (218 - 227 ه )؛ لأنّه أوّل من جلبهم إلى الديوان، ثمّ صار جلّ اعتماده عليهم في توطيد حكمه، فانخرطوا في صفوف الجيش، وترقّوا إلى الرتب والمناصب العالية، فقويت شوكتهم إلى أن تفرّدوا بالأمر ، غير تاركين لسادتهم الخلفاء سوى سلطة اسمية، وأصبح الخليفة كالأسير بيد حرسه.
وعانى بنو العبّاس من العنصر التركي وبال ماجنته أيديهم، وذاقوا منهم الأمرين، حتّى صار أمر البلاد بأيديهم يقتلون ويعزلون وينصبون من شاؤوا.
وفي عهد المستعين باللّه، غَلَب أوتامش ابن اُخت بغا الكبير على التدبير والأمر والنهي(1)، وكان المستعين أُلعوبة بيد وصيف وبغا الكبير، ثمّ خلعوه وبايعوا المعتزّ، ثمّ بدا لهم قتل المستعين فذبحوه كما تذبح الشاة، وحملوا رأسه إلى المعتزّ(2). وكذا المعتزّ فقد غُلِب على أمره، وتفرّد بالتدبير صالح بن وصيف(3).
وأمّا المهتدي (255 - 256 ه ) فقد خلعه الأتراك، وهجموا على عسكره فأسروه وقتلوه . وأمّا المقتدر فقد بايعه الأتراك وعزلوه ، ثمّ أعادوه أكثر من مرّة.
وأمّا القاهر باللّه (320 - 322 ه ) فسرعان ما خلعوه من السلطة، وسملوا عينيه بمسمار محمي حتّى سالتا على خدّيه. وكذا الراضي (322 - 329 ه ) ومن جاء بعده كالمتّقي (329 - 333 ه-)، والمستكفي (333 - 334 ه-) الذي دخل البويهيون في زمانه إلى بغداد، حيث سملت أعينهم جميعاً.
ص: 19
مرّت الوزارة في ظلّ الدولة العبّاسية في هذا العصر بتجارب قاسية، وثبت فشلها في عصر الكليني ببغداد، إذ أخفق الوزراء في أعمالهم، ولم يحسنوا القيام بأعباء وزاراتهم، وكان همّهم الاستحواذ على أكبر قدر من الأموال، غير آبهين بشؤون الدولة وأمن الناس، بل كانوا إلبا مع الأتراك في معظم ما حصل من عزل وتنصيب! ويكفي مثالاً على ما وصلت إليه الوزارة في زمان ثقة الإسلام ببغداد ما ذكره الصابي بشأن وزراء المقتدر كأبي الحسن بن الفرات الذي ولي الوزارة ثلاث دفعات ، وكان يُعزل بعد كلّ مرّة ويُهان ويحبس ويؤتى بوزير جديد، ثمّ يعزل الوزير الجديد ويهان ويحبس، ويعاد ابن الفرات للوزارة، وهكذا حتّى قُتل بعد عزله للمرّة الثالثة وقطعوا رأسه ورأس ولده المحسن(1).
بما أنّ الحديث عن هذه الثورات والتي أحاطت بالدولة من كلّ مكان يخرجنا عن أصل الموضوع، نشير إلى أهمّها كالآتي:
1 - الثورات العلوية: وهي كثيرة ، لا سيّما في مطلع ذلك العصر التي امتدّت من الطالقان شرقا، في حدود سنة (250 ه )، وإلى الدولة الفاطمية غربا في سنة (296 ه )(2).
2 - حركة الزنج: التي فتَّت عضد الدولة العبّاسية كثيرا وراح ضحيّتها أُلوف الناس(3).
3 - حركة القرامطة: وهي من أعنف الحركات وأكثرها خطورة لا على الحكومة العبّاسية فحسب، بل على الإسلام ومثله العليا أيضا، ولهذا تجرّد ثقة الإسلام
ص: 20
الكليني رحمه الله للردّ على هذه الحركة(1).
4 - ظهور الخوارج المارقة في الموصل(2).
بسبب ضعف السلطة المركزية ببغداد وتدهورها شهدت الدولة الإسلامية في عصر الكليني انفصالاً واسعا لبعض الأقاليم، واستقلالاً كليّا لجملة من الأطراف، كما هو حال الدولة الأموية في الأندلس والفاطمية في شمال أفريقيا وغيرها.
وصفوة القول: إنّ العصر العبّاسي الثاني الذي عاش الكليني أواخره ببغداد، كان عصرا مليئا بالمشاكل السياسية للأسباب المذكورة، وكان من نتائج ذلك أنْ عمّ الفساد، وانتشرت الرشوة، وضاعت الأموال، وابتعد الناس عن الإسلام ، لا سيّما (خلفاء المسلمين) وقادتهم ووزرائهم، وهذا ما دفع حماة الشريعة إلى ذكر فضائحهم وعتوّهم كلّما سنحت لهم الفرصة، كما فعل الكليني رحمه الله الذي بيّن في كتاب القضاء من الكافي تهافت أُصول نظريّات الحكم الدخيلة على الفكر الإسلامي، فضلاً عمّا بيّنه في كتاب الحجّة وغيره من كتب الكافي من انحراف القائمين على تلك النظريات الفاسدة بأقوى دليل، وأمتن حجّة، وأصدق برهان.
استمرّت الحياة الثقافية والفكرية في عصر الكليني ببغداد بسرعة حركتها أكثر بكثير ممّا كانت عليه في العصر العبّاسي الأوّل ، وقد ساعد على ذلك ما امتازت به بغداد على غيرها من الحواضر العلمية، بتوفّر عوامل النهضة الثقافية والفكرية فيها أكثر من غيرها بكثير؛ فهي عاصمة لأكبر دولة في عصر الكليني، وتمثّل دار الخلافة وبيت
ص: 21
الوزارة والإمارة، ومعسكر الجند، ورئاسة القضاء، وديوان الكتابة، وفيها بيت المال، وإليها يجبى الخراج. وأمّا موقعها الجغرافي فليس له نظير، فأهمّ الأقاليم الإسلامية يومذاك أربعة: بلاد فارس، والحجاز، ومصر، والشام ، وهي أشبه ما تكون بنقاط متناسبة البعد وموزّعة على محيط دائرة إسلامية مركزها بغداد.
كما ضمّت قبري الإمامين موسى بن جعفر، ومحمّد بن عليّ الجواد عليهماالسلام، ومن هنا فهي مهبط روحي للشيعة، وعامل جذب للعلماء من كلّ مذهب، فلا تكاد تجد فقيها أو مفسّرا أو محدّثا أو أديبا من سائر المسلمين إلاّ وقد شدّ ركابه إليها.
ثانياً : أوجه النشاط الثقافي والفكري والمذهبي ببغداد
الملاحظ في ذلك العصر هو اجتماع جميع المذاهب الإسلامية ببغداد، من الشيعة الإمامية، والزيدية، والواقفة، والمالكية، والشافعية، والحنبلية، والظاهرية، والطبرية، والمعتزلة، مع بروز عدد كبير من فقهاء كلّ مذهب، حتّى تألّق الفقة الإسلامي تألّقا كبيرا في هذا العصر، وممّن برز في هذا العصر جملة من أعلام وفقهاء سائر المذاهب الإسلامية .
فمن المالكية: إسماعيل بن إسحاق القاضي، وأبو الفرج عمر بن محمّد المالكي .
ومن الأحناف: عبدالحميد بن عبدالعزيز، وأحمد بن محمّد بن سلمة.
ومن الشافعية: محمّد بن عبداللّه الصيرفي، ومحمّد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي.
ومن الحنابلة الحشوية والمجسّمة: ابن الحربي، وعبداللّه بن أحمد بن حنبل.
ومن الظاهرية: محمّد بن علي بن داوود، وابن المغلّس أبو الحسن عبداللّه بن أحمد.
ومن الطبرية: مؤسّس المذهب الطبري محمّد بن جرير المفسّر.
ومن الشيعة الزيدية: عبدالعزيز بن إسحاق، أبو القاسم الزيدي المعروف بابن البقّال.
ص: 22
ومن الواقفة: محمّد بن الحسن بن شمّون، أبو جعفر البغدادي.
ومن المعتزلة: الجبائي المعتزلي، وكان رأسا في الاعتزال.
وأمّا الحديث عن فقهاء وعلماء الشيعة الإمامية ببغداد فسيأتي في مكان لاحق.
كما ازدهرت علوم اللغة العربية، وبرز عدد كبير من النحاة، والأدباء، والكتّاب، والشعراء من البغداديين أو الذين وصلوا إليها وأملوا علومهم على تلامذتها، من أمثال المبرد، وثعلب، والزجّاج، وابن السرّاج. ومن الشعراء: البحتري ، وابن الرومي وغيرهما. كما شهد النثر نقلة جديدة في تاريخه في هذا العصر ببغداد، وهو ما يعرف بالنثر الفنّي .
ومن خصائص هذا العصر التطوّر الكبير الذي شهده الخطّ العربي، حيث استُبدِل الخطّ الكوفي المعقّد بخطّ النسخ الرشيق السهل. ممّا ساعد على سرعة الكتابة والاستنساخ. كما نشط المؤلّفون في هذا العصر في علوم الشريعة الإسلامية وغيرها كالتفسير، والتاريخ، والجغرافية، والطبّ، والهندسة، والرياضيّات، والفلك، والفلسفة.
ومن معالم النشاط الثقافي في هذا العصر ببغداد الاندفاع نحو ترجمة الكتب النفيسة من السريانية، واليونانية، والفارسية إلى اللغة العربية.
ونتيجة منطقية لهذه الحركة الواسعة من التأليف والترجمة طفحت حوانيت الورّاقين بالكتب، وما أكثر الورّاقين ببغداد في ذلك العصر. وبلغ شغف العلماء بالكتب في عصر الكليني درجة تفوق الوصف، بحيث أنّ قسما منها كان يُكتب بماء الذهب، وكانت مكتبة سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة البويهي التي أنشأها بالكرخ من بغداد سنة (381 ه ) تضمّ الآلاف من تلك الكتب القيّمة. ولكن الطائفية البغيضة جنت على حضارة الأُمّة، فأحرقت بهمجيّتها تراثها العتيد.
ص: 23
هناك الكثير من الأُمور الغامضة في الحياة الشخصية لعباقرة الشيعة، لم تزل طرق البحث موصدة أمام اكتشافها؛ لعدم وجود ما يدلّ على تفاصيل تلك الحياة، خصوصا بعد حرق مكتبات الشيعة في القرن الخامس الهجري. ولا يفيدنا علم الرجال إلاّ شذرات من هنا وهناك. وأمّا علم التراجم، فعلى الرغم من تأخّر نشأته، وضياع أُصوله الاُولى، لا زال إلى اليوم يفتقر إلى الأُسس الموضوعية التي لابدّ من مراعاتها، ولا يكفي وصول بعض مؤلّفاتهم أو كلّها لإزالة ذلك الغموض؛ لاختصاص كلّ كتاب بموضوعه؛ فكتب الحديث مثلاً لا تدلّنا على أصل مؤلّفيها، ولا توقفنا على عمود نسبهم ولا تاريخ ولاداتهم أو نشأتهم، وهكذا في أُمور كثيرة أُخرى تتّصل بهويّتهم، وإن أفادت كثيرا في معرفة ثقافتهم وفكرهم وتوجّههم. وانطلاقا من هذه الحقائق المرّة سنحاول دراسة الهوية الشخصية للكليني بتوظيف كلّ ما من شأنه أن يصوِّر لنا جانبا من تلك الهوية، لنأتي بعد ذلك على دراسة شخصيته العلمية وبيان ركائزها الأساسية، كالآتي:
هو محمّد بن يعقوب بن إسحاق، بلا خلاف بين سائر مترجميه، إلاّ من شذّ منهم من علماء العامّة، كالوارد في الكامل في التاريخ في حوادث سنة (328 ه ) حيث قال:
وفيها تُوفّي محمّد بن يعقوب، وقُتِل محمّد بن علي أبو جعفر الكليني، وهو من أئمّة الإمامية، وعلمائهم(1).
ولعلّ من الطريف أنّي لم أجد من اسمه (محمّد بن علي بن إسحاق، أبو جعفر
ص: 24
الكليني) في جميع كتب الرجال لدى الفريقين، لا في عصر الكليني، ولا في غيره. ومنه يتبيّن غلط ابن عساكر وابن الأثير، وفي المثل: «أهل مكّة أعرف بشعابها».
يكنّى الكليني رحمه الله بأبي جعفر، بالاتّفاق، ولعلّ من المناسب أن نشير هنا إلى أنّ مؤلفي أهمّ كتب الحديث عند الإمامية وهم المحمّدون الثلاثة، كلّهم يُكنّى بأبي جعفر.
عُرِف قدس سره بألقاب كثيرة يمكن تصنيفها - بحسب ما دلّت عليه - إلى صنفين، هما:
وهي أربعة ألقاب، دلّ الأوّل والثاني منها على المكان الذي ولد فيه ونشأ وتربّى وأخذ العلم في ربوعه، بينما دلّ الثالث والرابع على المكان الذي استقرَّ فيه إلى أن وافاه الأجل:
هو نسبة إلى «كُلَيْن»، قرية من قرى الريّ. وهذا اللقب من أشهر ألقابه المكانية قاطبة، ومن شهرته أنّه غلب على اسمه، ولا ينصرف إلى أحد - عند الإطلاق - إلاّ إليه، على الرغم ممّن تلقّبوا به قبله أو بعده.
جدير بالذكر أنّ قرية كلين اختلف العلماء في ضبطها كثيرا، كما اختلفوا في تحديد موقعها الجغرافي أيضا، الأمر الذي لابدّ من تناوله فنقول:
تقع قرية كُلَيْن جنوب مدينة الريّ التابعة لطهران، وهي تابعة - حسب التقسيم الإداري حالياً - إلى مدينة حسن آباد الواقعة على طريق (طهران - قمّ) على يسار القادم من طهران، ويبعد مدخلها عن طهران بمسافة (35) كيلومتراً، وعن قمّ (91) كيلومتراً. ومن مدخل المدينة إلى رأس هذا الشارع مسافة (4) كيلومترات.
ص: 25
هو نسبة إلى الريّ، المعروفة حاليا باسم (شهر ري) أي مدينة الري، وهي من الأحياء الكبيرة في جنوب العاصمة طهران، وحرف (الزاي) من زيادات النسب.
وسبب تلقيب الكليني رحمه الله بالرازي إنّما هو على أساس تبعية قرية كلين لمدينة الري، مع أنّ الكليني قد سمع الحديث من مشايخ الري، وروى عنهم كثيرا جدّا في الكافي، ممّا يشير إلى انتقاله إلى الري في بداية حياته العلمية، وبقائه فيها إلى أن بلغ ذروة شهرته، حتّى قال النجاشي في ترجمته: «شيخ أصحابنا في وقته بالري، ووجههم»(1).
وهو نسبة إلى بغداد عاصمة الدولة العبّاسية، وهذا اللقب والذي يليه هما من ألقابه المكانية المعبّرة عن تحوّله من الري إلى بغداد، حيث بقي فيها زهاء عشرين عاما إلى أن وافاه أجله المحتوم.
عرف الكليني رحمه الله بلقب (السلسلي) نسبة إلى درب السلسلة ببغداد، حيث نزل في هذا الدرب واتّخد له مسكنا هناك، ويقع هذا الدرب في منطقة باب الكوفة ؛ أحد أبواب بغداد الأربعة، وتقع في الجانب الشرقي من بغداد في محلّة الكرخ.
هي الألقاب التي عبّرت عن شخصيّة الكليني العلميّة، ويمكن تقسيمها إلى قسمين، هما:
ص: 26
وُصِفَ الكليني على لسان الكثير من علماء العامّة بأوصاف علمية لا تقلّ عمّا وصفه به علماء الإمامية، ومن تلك الألقاب الكثيرة لقب (المجدّد) يعني: مجدّد المذهب الإمامي على رأس المئة الثالثة.
لمّا كان الكليني رحمه الله «. .. في العلم، والفقه، والحديث، والثقة، والورع، وجلالة الشأن، وعظم القدر، وعلوّ المنزلة، وسموّ الرتبة، أشهر من أن يحيط به قلم، ويستو فيه رقم»(1) فلا غرو في أن يوصف بما يليق بشأنه، ولكثرة تداول بعض تلك الأوصاف صارت علما له مثل: (رئيس المحدّثين)، إلاّ أنّ شهرة الشيخ الصدوق بهذا اللقب جعلته ينصرف إليه عند الإطلاق، خصوصا مع قلّة استعماله بحقّ الكليني في الكتابات المعاصرة، وغلبة لقب (ثِقة الإسلام) الذي صار علما للكليني رحمه الله دون من سواه.
وسنبحثها من جهتين، وهما:
1 - تاريخها: لم يؤرّخ أحد ولادة الشيخ الكليني، ولهذا يتعذّر علينا معرفة مدّة عمره بالضبط . نعم يمكن تلمّس القرائن التي تفيدنا - على نحو التقريب - في تقدير عمره، ومن تلك القرائن:
أ - إنّه وُصِفَ من المجدّدين على رأس المئة الثالثة، والمجدّد لا يكون مجدّدا دون سنّ الأربعين عادةً، وهذه القرينة تعني أنّ ولادته كانت في حدود سنة (260 ه ).
ب - إنّه حدّث في الكافي عن بعض المشايخ الذين ماتوا قبل سنة (300 ه )،
ص: 27
كالصفّار (ت 290 ه )، والهاشمي (ت 291 ه )، والأشعري الذي مات قبل الصفّار، وسهل بن زياد الذي مات قبل الأشعري(1)، وهذه القرينة تساعد التقريب المذكور.
ج - إنّه كان ألمع شخصية إمامية في بلاد الري قبل رحلته إلى بغداد ، كما يدلّ عليه قول النجاشي ، مع كثرة علماء الشيعة بالري في عصر الكليني، وإذا علمنا أنّه غادر الري إلى العراق قبل سنة (310 ه )، أمكن تقدير عمره يوم مغادرته بنحو خمسين عاما أو أقلّ منه بقليل، وهو العمر الذي يؤهّله لزعامة الإمامية في بلاد الري.
د - إنّ غرض الكليني من تأليف الكافي هو أن يكون مرجعا للشيعة في معرفة أُصول العقيدة وفروعها وآدابها، بناءً على طلب قُدِّم له في هذا الخصوص ، كما هو ظاهر من خطبة الكافي، ومثل هذا الطلب لا يوجّه إلاّ لمن صَلُبَ عوده في العلم، وعرفت كفاءته، وصار قطبا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الخطير. وعليه، فإن قلنا بأنّ سنة (290 ه ) هي بداية الشروع في تأليف الكافي بناءً على وفاة بعض مشايخه حدود هذا التاريخ، فلا أقلّ من أن يكون عمره وقت التأليف ثلاثين عاما إن لم يكن أكثر من ذلك، وهذا يؤيّد التقدير المذكور.
2 - مكانها: الظاهر أنّ مكان ولادة الشيخ الكليني رحمه الله هو قرية كُلَين، وهناك جملة من القرائن القوية الدالّة على ذلك، هي:
أ . النسبة إلى كلين، بلحاظ أنّ الرحلة لا تكون إلى القرى عادةً، بل غالبا ما تكون من القرى إلى حواضر العلم والدين المشهورة، وعليه فنسبته إلى تلك القرية يشير إلى ولادته فيها، ونشأته الاُولى بين ربوعها .
ب . إنّ قبر والده الشيخ يعقوب لا زال قائما إلى اليوم في قرية كلين.
ج . أخو الشيخ الكليني منسوب إلى كلين، وهو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني.
د . أُمّ الشيخ الكليني وأخوها وأبوها وعمّها وجدّها من أهل تلك القرية ، كما
ص: 28
سيأتي في بيان نشأته وأسرته.
ه- . مشايخه الأوائل الذين تلقّى العلم عنهم كانوا من كلين.
وكلّ هذا ينفي القول بولادته في مكان آخر، ومنه يتبيّن خطأ الأستاذ عبدالواحد الأنصاري بقوله: «ولد الكليني ببغداد»(1) ولعلّه اشتبه بوفاته في بغداد.
نشأ في قرية كُلَين الصغيرة وانتسب إليها، فكان أشهر أعلامها في تاريخها القديم والمعاصر. وعاش طفولته في بيت جليل أبا وأُمّا وإخوة وأخوالاً، وتلقّى علومه الأُولى من رجالات العلم والدين من أهل تلك القرية، لا سيّما من أُسرته.
ويبدو أنّ لتلك القرية ثقلاً علميا معروفا في ذلك الحين؛ إذ خرّجت عددا من الأعلام لا زال ذكرهم يتردّد في كتب الحديث والرجال، كإبراهيم بن عثمان الكليني، وأبي رجاء الكليني، وغيرهما.
وإذا ما وقفنا على من برز من أُسرة الكليني وأخواله، علمنا أنّه لم يفتح عينيه على محيط مغمور ثقافيا، وإنّما توفّرت له في محيطه وأُسرته الأسباب الكافية لأن تكون له نشأة صالحة أهّلته في أوان شبابه لأن يتفوّق على أقرانه. فأبوه الشيخ يعقوب بن إسحاق الكليني رحمه الله من رجالات تلك القرية المشار لهم بالبنان(2). وأمّا أُمّه فهي امرأة جليلة فاضلة؛ حيث تلقّت تربية حسنة، وعاشت حياتها قبل زواجها في بيت من البيوتات المعروفة في تلك القرية، وهو البيت المشهور ببيت علاّن.
وبمناسبة الحديث عن الأُسرة التي احتضنت ثقة الإسلام، نودّ التذكير بأمرين:
أحدهما: سؤالنا القديم الذي مضى على طرحه زهاء عشرين عاما: «هل للكليني ولد»؟ ولم يزل إلى الآن بلا جواب محكم، حيث لم أجد - رغم التتبّع الطويل
ص: 29
الواسع - ما يشير إلى النفي أو الإثبات بشكل قاطع.
والآخر: في خصوص أصل الكليني، إذ لا دليل على انحداره من أُصول فارسية، خصوصا وأنّ اسم جدّه الأعلى ليس من أسماء الفرس، فاسم جدّ البخاري صاحب الصحيح مثلاً هو بردزبه، وهو من أسماء المجوسية، ولا يكفي الانتساب إلى كلين والولادة فيها على تثبيت الأصل الفارسي. كما لا دليل على انحدار ثقة الإسلام من أُصول عربية أيضا، وربّما قد يُستفاد من الكافي نفسه ما يشير عن بعد إلى عدم فارسيّته، فقد روى بسنده عن محمّد بن الفيض، عن الإمام الصادق عليه السلام بأنّ «النرجس من ريحان الأعاجم» ، ثمّ قال معقّبا: «وأخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إن صاموا، وقالوا: إنّه يمسك الجوع»(1)، حيث إنّه لو كان من الأعاجم أصلاً لما احتاج إلى الرواية بنسبة شمّ الريحان إليهم، بل يؤكّده بنفسه؛ لعدم خفاء ذلك على من انحدر منهم، ولكنّه دليل ضعيف.
اختلف العلماء في ضبط تاريخ وفاته على قولين، هما:
الأوّل : تحديد تاريخ الوفاة بسنة (328 ه )، قال الشيخ الطوسي في الفهرست:
توفّي محمّد بن يعقوب سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة ببغداد، ودُفن بباب الكوفة في مقبرتها(2).
وتابعه على ذلك السيّد ابن طاووس(3)، واختاره من العامّة ابن ماكولا(4)، وابن عساكر الدمشقي(5)، وغيرهما .
ص: 30
الثاني : تحديد تاريخ الوفاة بسنة (329 ه )، وهو القول الثاني للشيخ الطوسي، قال في الرجال:
مات سنة تسع وعشرين وثلاثمئة في شعبان ببغداد، ودفن بباب الكوفة(1).
واختاره النجاشي، قال:
ومات أبو جعفر الكليني رحمه الله ببغداد، سنة تسع وعشرين وثلاثمئة سنة تناثر النجوم، وصلّى عليه محمّد بن جعفر الحسني أبو قيراط(2).
وذهب إلى هذا القول من العامّة أبو الفداء(3)، وإسماعيل باشا البغدادي(4).
وهذا القول هو الراجح ؛ لجملة من الأُمور، هي:
أ . إنّ أسبق مصادر القول الأوّل الذي حدّد وفاة الكليني رحمه الله بسنة (328 ه ) هو فهرست الشيخ الطوسي، ولا يبعد أن يكون هو المصدر الأساس لبقيّة الكتب التي حدّدت الوفاة بتلك السنة سواءً كانت شيعيّة، أو غيرها.
ب . المشهور هو أنّ الشيخ الطوسي ألّف كتاب الفهرست قبل كتاب الرجال، وهذا يعني أنّ قوله في الرجال الموافق لقول النجاشي بمثابة الرجوع عن قوله السابق.
ج . توفّر القرينة الدالّة على صحّة سنة (329 ه )، وهي ذكر شهر الوفاة، وهو شهر شعبان كما مرّ في كلام الشيخ الطوسي في رجاله، في حين تفتقر سنة (328 ه ) إلى مثل هذا التحديد.
جدير بالذكر إنّ شهر شعبان من سنة (329 ه ) يصادف شهر مايس من سنة 941 م، وشهر أرديبهشت من سنة 322 ه . ش .
اتّفق الكلّ على أنّ وفاته كانت ببغداد، ولم أجد المخالف في هذا إلاّ ما كان من
ص: 31
أحمد أمين المصري (ت 1373 ه ) الذي زعم أنّ وفاة الكليني بالكوفة(1). والمعروف عن أحمد أمين أنّه لم يطّلع على كتب الشيعة في خصوص معرفة عقائدهم وأعلامهم.
وخرجت جموع الشيعة ببغداد في ذلك اليوم الحزين لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمان عالمها وفقيهها ومحدّثها الشيخ الكليني رحمه الله ، واحتشدت بخشوع ليؤمّها
في الصلاة نقيب الطالبيين ببغداد السيّد محمّد بن جعفر الحسني المعروف بأبي قيراط، ثمّ نقلته بعد ذلك إلى مثواه الأخير.
جدير بالذكر، أنّه قد شهدت بغداد وغيرها في سنة (329 ه ) وفيات عدد من أقطاب الإمامية، كالشيخ الصدوق الأوّل، والسفير الرابع الشيخ علي بن محمّد السَّمُري، كما مات فيها عدد جمّ من علماء الطوائف والمذاهب الأُخرى من فقهاء ومتكلّمين ومحدّثين، حتّى سمّيت تلك السنة بسنة موت العلماء، وحصل في تلك السنة من الأحداث ما لم يعهد مثله، كتناثر النجوم فيما قاله النجاشي، مع مطر عظيم، ورعد هائل، وبرق شديد فيما قاله الخطيب البغدادي(2)، ممّا يدلّ على شؤم تلك السنة.
يُعلم ممّا تقدّم أنّ مكان قبر الكليني في الجانب الغربي من بغداد؛ لتصريح الشيخ الطوسي وغيره بأنّه دُفن ببغداد في مقبرة باب الكوفة، قرب صراة الطائي، وقد رأى الشيخ أحمد بن عبدالواحد المعروف بابن عبدون قبر الشيخ الكليني في صراة الطائي وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيه.
وصراة الطائي اسم لنهرين ببغداد وكلاهما في الجانب الغربي من بغداد ؛
ص: 32
أحدهما: يُسمّى الصراة العظمى، أو الصراة العليا. والآخر: يُسمّى الصراة الصغرى، أو الصراة السفلى، ومنبعهما من نهر عيسى الأعظم الذي يأخذ ماءه من جنوب بغداد، وتحديدا من المنطقة المسمّاة حاليا بجزيرة بغداد.
ولكنّ القبر المنسوب إلى الشيخ الكليني رحمه الله يقع اليوم في منطقة الرصافة على الضفّة الشرقية لنهر دجلة، وبالضبط في جامع الصفوية سابقا، والآصفية حاليا ، جنب المدرسة المستنصرية على يمين العابر من الكرخ إلى الرصافة على جسر المأمون الحالي، ولا يفصل هذا الجامع عن نهر دجلة إلاّ بضعة أمتار، وإلى جانبه قبر آخر في الجامع نفسه.
وقد تعرّض القبر المذكور إلى محاولة هدمه في زمان العثمانيين، وحُفر القبر في زمانهم فوجدوا الشيخ بكفنه وكأنّه دُفِن قبل ساعات، ثمّ شُيِّد القبر وبُنيت عليه قبّة عالية. وتعرّض للهدم أيضا في عهد الاحتلال الانجليزي للعراق، فانتفض الشيعة تجاه تلك المحاولة الخسيسة.
بذل الشيخ الكليني رحمه الله جهدا مميّزا في تأليف كتاب الكافي وتصنيفه بعد عملية جمع وغربلة واسعة لما روي عن أهل البيت عليهم السلام في أُصول الشريعة وأحكامها وآدابها، كما يشهد بذلك تلوّن الثقافة الإسلامية الواسعة المحتشدة في كتاب الكافي (أُصولاً، وفروعا، وروضة)، ومن الواضح أنّه ليس بوسع (كُلَيْن) تلك القرية الصغيرة تلبية حاجة الكليني لتلك المهمّة الخطيرة، ومن هنا تابع رحلته وعزم على سفر طويل لطلب العلم، خصوصا وأنّه لابدّ من الرحلة في ذلك الوقت كما يقول ابن خلدون(1)،
ص: 33
ولهذا لم يكتف أحد من علماء الحديث وأقطابه في حدود مدينته.
ولهذا طاف الكليني في الكثير من حواضر العلم والدين في بلاد الإسلام، وسمع الحديث من شيوخ البلدان التي رحل إليها. فبعد أن استوعب ما عند مشايخ كُلَيْن من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، اتّجه إلى الريّ لقُربها من كُلَيْن، فاتّصل بمشايخها الرازيّين، وحدّث عنهم. ولا يبعد أن تكون الري منطلقَه إلى المراكز العلمية المعروفة في بلاد العجم ومن ثَمَّ العودة إلى الريّ؛ إذ التقى بمشايخ من مدنٍ شتّى وحدّث عنهم؛ فمن مشايخ قمّ الذين حدّث عنهم: أحمد بن إدريس ، وسعد بن عبداللّه بن أبي خَلَف الأشعري وغيرهما. كما حدّث عن بعض مشايخ سمرقند كمحمّد بن علي الجعفري ، ونيسابور كمحمّد بن إسماعيل النيسابوري ، وهمدان ، كمحمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني .
وبعد أن طاف الكليني في المراكز العلمية في إيران رحل إلى العراق واتّخذ من بغداد قاعدة للانطلاق إلى المراكز العلمية الأُخرى، إلى أن وافاه أجله المحتوم فيها. فقد حدّث بعد ارتحاله من بغداد إلى الكوفة عن كبار مشايخها، كأبي العبّاس الرزّاز الكوفي، وحميد بن زياد الكوفي، كما رحل إلى الشام بعد أن وقف على منابع الحديث ومشايخه في العراق ، وحدّث ببعلبك ، كما صرّح بهذا ابن عساكر الدمشقي في ترجمة ثقة الإسلام(1).
لم تكن هجرة الكليني قدس سره من الري إلى بغداد هجرة مجهولة السبب(2)، ولا تأثّرا بالمنهج العقلي الذي عُرِفت به المدرسة البغدادية ، كما لم تكن هجرة الكليني إلى بغداد بدوافع سياسية من قبل البويهيين، كما توهّمه صاحب كتاب الكليني
ص: 34
والكافي(1) ، بل كانت لاعتبارات علمية محضة، فبغداد مركز الحضارة، وملتقى علماء المذاهب من شتّى الأمصار، ومستوطن السفراء الأربعة رضوان اللّه تعالى عليهم.
ومن ثمّ فقد غادر الري بعد تجوال طويل في بلاد إيران، فكان عليه الانتقال إلى بغداد؛ لتكون منطلقه إلى مدن العراق والبلاد المجاورة كالشام والحجاز، خصوصا وأنّ العراق يمثّل مركز الثقل الأعظم لتراث أهل البيت عليهم السلام.
وأمّا عن ادّعاء التأثّر بالمنهج العقلي، والإيحاء بأنّه السبب المباشر في هجرة الكليني إلى بغداد دون قمّ فهو زعم باطل من وجوه عديدة، نشير لها باختصار:
الوجه الأوّل: إنّه لو أُجري مَسْحٌ شامل لأحاديث الكافي وتمّ إرجاعها إلى مشايخ الكليني المباشرين ، لوجدت أكثر من ثلثي الكافي يرجع إلى مشايخه القمّيين دون غيرهم.
الوجه الثاني: المعروف أنّ الكليني يحدّث عن سهل بتوسّط (العدّة) غالبا، وبدونها أحيانا، وإذا عُدنا إلى رجال عدّة الكافي عن سهل لا نجد فيهم بغداديا واحدا، بل كلّهم من بلاد الريّ، وما رواه عنه من غير توسّط العدّة فجميعه عن القمّيين.
الوجه الثالث: روايات الكافي وإن تناولت الكثير من المباحث العقلية ، إلاّ أنّها مسندة إلى أهل البيت عليهم السلام، واختيارها لا يكوّن علامةً فارقةً في التأثّر بالمنهج العقلي، ولتأثّر مدرسة قمّ وقادتها بتلك الروايات أكثر من الكليني عدّة مرّات .
الوجه الرابع: ما ورد في ديباجة الكافي يشهد على بُطلان الزعم المذكور ؛ إذ بيّن الكليني أنّه سيتبع المنهج الروائي في تحصيل الأحاديث الشريفة، بل صرّح بعجز العقل عن إدراك جميع الأحكام، وأنّ المُدْرَك منها ما هو إلاّ أقلّها.
الوجه الخامس: إنّ سهل بن زياد نفسه كان من مشهوري الرواة، ومنهجه روائي بحت، وليست له آراء عقلية في مرويّاته، حتّى يُدعى تأثّره بالمنهج العقلي، كما أنّ
ص: 35
مرويّاته في الكافي لم تنحصر بأُصوله التي ردّت على الأفكار والاتّجاهات السائدة في ذلك العصر، وإنّما كان جلّها في الأحكام الشرعية الفرعيّة التي لا تختلف بين روّاد مدرستي قمّ وبغداد.
تتلمذ الشيخ الكليني رحمه الله على مشاهير الشيعة في شرق البلاد الإسلامية وغربها ، وروى الحديث عن أعلام الأُمّة في الكافي وغيره من كتبه، وهم:
قال النجاشي:
أحمد بن إدريس بن أحمد أبو علي الأشعري القمّي، كان ثقةً، فقيهاً في أصحابنا، كثير الحديث، صحيح الرواية، له كتاب النوادر...(1).
وهو من مشايخ ابن قولويه، ومحمّد بن الحسن بن الوليد، والصدوق الأوّل، ومن أشهر ثلامذته ثقة الإسلام الكليني رحمه الله ، فقد اعتمده في روايات كثيرة في الكافي، قد تزيد على خمسمئة رواية، مصرّحا باسمه تارةً، وبكنيته أُخرى، وهو من رجال عِدَّة الكافي الذين روى عنهم الكليني عن الأشعري.
هو أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، حفيد أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، وروى عنه. وهو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني ، روى عنه في الكافي في عدّة موارد مصرّحاً باسمه(2)، بل هو من رجال عِدّة الكليني الذين يروي
ص: 36
عنهم عن البرقي ، كما ذكره العلاّمة الحلّي في الخلاصة.
قال النجاشي:
هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ، وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتّى مات، وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم، ومداخلته إياهم، وعظم محلّه، وثقته، وأمانته(1).
وقال الشيخ:
وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر (2) .
ووصفه الذهبي بأنه نادرة الزمان، وقال:
طلب الحديث سنة بضع وستين ومئتين وكتَبَ منه ما لا يحد ولا يوصف عن خلق كثير بالكوفة وبغداد ومكة(3).
ومات سنة (333 ه )، وله في الكافي عِدّة روايات.
روى له الكليني في كتاب الصيام من فروع الكافي حديثا واحدا(1)، وهو مشترك بين جماعة بهذا الاسم. وأحمد هذا ثقة معروف، قال النجاشي:
وكان أبو الحسن أحمد بن محمّد ثقة في الحديث(2).
أبو جعفر الأشعري القمّي، من مشاهير الفقهاء والمحدّثين الأجلاّء، اتّفق الكلّ على جلالته ووثاقته، قال النجاشي :
شيخ القمّيين، ووجههم، وفقيههم غير مدافع، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقى
السلطان، ولقي الرضا عليه السلام ، وله كتب، ولقي أبا جعفر الثاني، وأبا الحسن العسكري عليهماالسلام...(3) .
روى الكليني عنه ما يقرب من ألف حديث في الكافي ، وأكثرها عن محمّد بن يحيى، عنه، ثمّ عن عدّة من أصحابنا، عنه، كما روى عنه بوسائط أُخرى في موارد قليلة. نعم ربّما يبدأ إسناد الكافي أحيانا بأحمد بن محمّد بن عيسى من باب تعليق الإسناد على سابقه، ولكن وقع في موردين(4) من الكافي في بداية الإسناد ، ولا تعليق في المقام، وحمله على التعليق خلاف المصطلح.
أحد مشايخ الكليني المعتمدين لديه، روى عنه اثنين وخمسين حديثا(5)، واختلف المتأخّرون في حاله، والصحيح وثاقته، بل جلالته، وإكثار ثقة الإسلام من الرواية
ص: 38
المباشرة عنه مع الترحّم عليه(1)، قرينتان قويّتان على ذلك، ولا يمكن اغفالهما بحال .
هو أحد مشايخ الكليني، روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الشيخ المفيد وابن الغضائري وغيرهما معبّرا عنهم بلفظ (جماعة)، عن جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزُّرَاري وغيرهما، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب(2).
روى له الكليني حديثا واحدا في روضة الكافي(3)، والحديث مرسل، ويحتمل
إرساله من الكليني إلى إسماعيل بن عبداللّه القرشي ؛ لوجود بعض الرواة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بهذا الاسم وهم من قريش ، وعلى هذا لا يكون الرجل من مشايخه.
روى له حديثين في الكافي ، وهو من مشايخ الصدوق الأوّل علي بن بابويه القمّي رضى الله عنه.
روى الكليني عن الحسن بن خفيف، عن أبيه خبرا واحدا في خصوص بعث الإمام الحجّة عليه السلام بخادمين إلى مدينة الرسول صلى الله عليه و آله . والحسن هذا إمامي كما يظهر من روايته، إلاّ أنّه مجهول الحال عند بعضهم.
ص: 39
هذا السيّد من مشايخ الصدوق الأوّل المعاصر للكليني، فقد روى عنه كتاب زكّار بن يحيى كما في الفهرست(1). ولم يقع بهذا العنوان في جميع أسانيد الكافي، ولم يروِ أحد عن الكليني عنه بهذا العنوان أيضا، وإنّما وقع بعنوان (الحسن بن علي العلوي) تارةً، و(الحسين بن علي العلوي تارةً أُخرى. والجميع واحد كما نبّه عليه غير واحد من علماء الرجال(2).
من مشايخ الكليني، وله جملة يسيرة من الروايات في الكافي ، رواها عن محمّد
بن الحسين ومحمّد بن عيسى ومحمّد بن عيسى بن عبيد ومحمّد بن موسى، وعنه في الجميع الكليني رحمه الله (3).
«الحسين بن أحمد بن هلال»(1). وهو مقبول الرواية حسن، وليس بمجهول بعد اتّفاق الشيخين على روايته.
من مشايخه وقد ذكره ابتداءً في سبعة أحاديث فقط من أحاديث الكافي(2).
من أجلاّء مشايخ الكليني، روى عنه أكثر من أربعمئة حديث في الكافي، ووقع في كثير من أسانيد روايات الكتب الأربعة، وقد بلغت بإحصاء السيّد الخوئي ثمانمئة وتسعة وخمسين موردا(3). وجاء اسمه في أسانيد الكافي تارةً بعنوان: «الحسين بن محمّد»، وأُخرى «الحسين بن محمّد الأشعري»، وثالثة «الحسين بن محمّد بن عامر»، ورابعة «أبو عبداللّه الأشعري».
وقد ترجم له ابن حجر قائلاً:
الحسين بن أحمد بن عامر الأشعري، ذكره علي بن الحكم في شيوخ الشيعة، وقال:
كان من شيوخ أبي جعفر الكليني صاحب كتاب الكافي، وصنّف الحسين كتاب طبّ أهل البيت، وهو من خير الكتب المصنّفة في هذا الفنّ(4).
روى عنه الكليني أكثر من ثلاثمئة حديث توزّعت على جميع أجزاء الكافي . قال النجاشي:
ص: 41
حُمَيْد بن زياد بن حمّاد بن حمّاد هوار الدِهْقان، أبو القاسم، كوفي سكن سورا وانتقل إلى نينوى ... كان ثقة، واقفا، وجها فيهم، سمع الكتب، وصنّف كتاب الجامع في أنواع الشرائع، كتاب الخمس، كتاب الدعاء، كتاب الرجال - إلى أن قال : - ومات حُمَيْد سنة عشر وثلاثمئة(1).
ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن عيسى الأشعري عند ذكر كتابه النوادر(2). وترجم له في مكانٍ لاحق قائلاً:
داوود بن كُوْرَة أبو سليمان القمّي، وهو الذي بوّب كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى، وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب السرَّاد على معاني الفقه، له كتاب الرحمة في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ...(3).
وهو من رجال عِدّة الكافي الذين يروي الكليني بتوسّطهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وبهذا صرّح النجاشي في ترجمة الكليني(4) .
قال النجاشي:
سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الأشعري القمّي أبو القاسم، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً، وسافر في طلب الحديث. لقي من وجوههم الحسن بن عَرَفة، ومحمّد بن عبد الملك الدقيقي، وأبا حاتم الرازي، وعبّاس الترقُفي. ولقي مولانا أبا محمّد عليه السلام ، ورأيت بعض أصحابنا يضعّفون لقاءه لأبي محمّد عليه السلام ، ويقولون: هذه حكاية موضوعة عليه، واللّه أعلم... وصنّف سعد كتباً كثيرة - إلى أن قال - تُوفّي سعد رحمه اللّه سنة إحدى وثلاثمئة، وقيل: سنة
ص: 42
تسع وتسعين ومئتين(1).
من مشايخ الكليني، روى عنه في الكافي أحاديث كثيرة مباشرة وبلا تعليق، والقول بتلمذة الكليني على يديه خلاف المشهور، نظرا لروايته عن سهل أكثر من ألف حديث بواسطة علي بن محمّد، أو محمّد بن الحسن، أو كلاهما عنه، وكذلك بواسطة عِدّة من أصحابنا عنه.
وهذا لا يمنع من الرواية عنه بلا واسطة، خصوصا وأنّ إمكان اللقاء به في الريّ أو بغداد ممكن، ومن ثم فإنّ الالتزام بعدم اللقاء يعني التدليس ، إذ لا تعليق في جميع الأسانيد التي سنذكرها على أسانيد سابقه في الكافي، والتدليس منتفي عن ثقة الإسلام بالإجماع . هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فإنّ منهج الكليني أنْ يبتدئ في الإسناد بذكر أحد من مشايخه، ومَن وقع فيه ابتداءً ولم يعاصره الكليني فإنّما هو للإشعار بأخذ الحديث من كتابه والطريق إليه معلوم من سابقه.
هو من أعاظم ثقات القمّيين ومشاهيرهم، بل من الأجلاّء المعروفين بلا خلاف، قال النجاشي في ترجمته: «شيخ القمّيين ووجههم...»(2).
روى عنه الكليني أكثر من أربعة آلاف حديث في كتاب الكافي، فضلاً عن اشتراكه
مع غيره في الرواية عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، وأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري بلفظ «عدّة من أصحابنا».
ص: 43
قال النجاشي:
علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح
المذهب(1).
ولعلي بن إبراهيم رضى الله عنه مرقد مشهور في مدينة قمّ المشرفة لا زال شاخصاً إلى الآن يؤمّه العارفون لحقّه من كلّ حدبٍ وصوب.
محدّث، جليل، نسّابة، ثقة، روى له الكليني في الكافي أربعة أحاديث فقط، اثنين منها مباشرة(2)، واثنين بالواسطة(3).
قال النجاشي:
علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن ... أبو الحسن الجواني، ثقة، صحيح الحديث،
له كتاب أخبار صاحب فخ، وكتاب أخبار يحيى بن عبداللّه بن حسن(4).
هو من مشايخ الكليني، ذكره الشيخ في رجاله، قائلاً:
يروي عنه الكليني رحمه الله ، وروى عنه الزُّرَاري رحمه الله ، وكان معلّمه(5).
كما ذكره الزُّرَاري في رسالته في آل أعين مصرّحاً بأنّه مؤدّبه(6).
من مشايخ الكليني، لم يروِ عنه في الكافي، ومن وقع في إسناده بهذا الاسم فهو
ص: 44
غيره .
قال الشيخ الصدوق:
حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام رضى الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب، قال: حدّثنا علي بن محمّد بن سليمان ...(1).
ورواية الشيخ الصدوق المذكورة لم يروها الكليني في الكافي ، نعم وقع في الكافي علي بن محمّد بن سليمان النوفلي في حدود ستّ روايات، وهو يروي عنه بواسطتين تارةً ، وبثلاث وسائط أُخرى. ويظهر أنّ المذكور في إسناد الشيخ الصدوق يختلف عمّن وقع بهذا الاسم في أسانيد الكافي ؛ لجملة من القرائن.
هو من مشايخ الكليني، روى عنه في الكافي كثيراً جدّاً، فضلاً عمّا رواه عنه في ضمن رجال عِدَّته عن البرقي، وقد يعبّر عنه بلفظ علي بن محمّد بن بُنْدار.
قال النجاشي:
علي [بن محمّد(2)] بن أبي القاسم، عبد اللّه بن عمران البرقي، المعروف أبوه بماجيلويه، يُكنّى أبا الحسن، ثقة، فاضل فقيه، أديب، رأى أحمد بن محمّد البرقي، وتأدّب عليه، وهو ابن بنته(3).
هو أحد مشايخ الكليني، ويُلقّب بالكليني الرازي ، ويُعرف بعَلاّن. وهو خال الكليني وأُستاذه، ومن رجال عِدّة الكافي الذين روى عنهم عن سهل بن زياد ، وقد وثقّه جميع من ترجم له؛ قال النجاشي:
ص: 45
علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني، المعروف بعَلاّن، يكنى
أباالحسن، ثقة، عين، له أخبار القائم عليه السلام (1).
من مشايخ العِدّة الّذين يروي عنهم الكليني ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي . وقد روى الكليني سائر كتب أحمد بن عيسى الأشعري عن الكُمنداني وجماعته عنه(2).
روى الكليني عنه مضموما إلى العِدّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أحاديث كثيرة قد تزيد على سبعمئة حديث موزّعة على جميع أجزاء الكافي، كما روى عنه منفردا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(3).
من أهل آذربيجان، ولد سنة (187 ه ) وتوفّي سنة (304 ه ) ، فقد بصره رضى الله عنه بعد الثمانين ثمّ رُدَّت له عيناه قبل وفاته بسبعة أيّام ، وهو من مشايخ الكليني الثقات الأجلاّء، روى عنه في الكافي في موردين ، وكنّاه بأبي محمّد مع الترحّم عليه في
أوّلهما(4).
وعدّه الشيخ الصدوق والعلاّمة الطبرسي ممّن شاهد مولانا الإمام الحجّة عليه السلام من الوكلاء من أهل آذربيجان(5).
من محدّثي العامّة ورواتهم، روى عنه الشيخ الكليني رحمه الله ، وليس له في الكافي أيّ
ص: 46
حديث. قال ابن عساكر في ترجمة الكليني:
قدم دمشق، وحدّث ببعلبك عن أبي الحسين محمّد بن علي الجعفري السمرقندي، ومحمّد بن أحمد الخفّاف النيسابوري ...(1).
من مشايخ الكليني، حدّث عنه ببغداد كما في لسان الميزان(2)، وهو غير محمّد بن
أحمد بن عبد الجبّار المعروف بمحمّد بن أبي الصهبان القمّي الذي حدّث عنه الكليني بالواسطة في جملة من أحاديث الكافي . وليس لمحمّد هذا رواية في الكافي .
من مشايخ ثقة الإسلام، روى عنه في روضة الكافي(3) ، ومن مشايخ الصدوق الأوّل أيضاً.
من مشايخ الكليني قدس سره، وقد تردّد بعضهم في تشخيص محمّد بن إسماعيل هذا المبدوء به في أوائل أسانيد الكافي أُصولاً وفروعا وروضةً ، وبصورة كثيرة تدلّ على اعتماد ثقة الإسلام على ما يرويه ، وسبب التردّد المذكور، هو اشتراك جماعة من الرواة بهذا الاسم، أشهرهم ثلاثة، هم: «محمّد بن إسماعيل النيسابوري» «محمّد بن إسماعيل البرمكي» «محمّد بن إسماعيل بن بزيع».
وانتهت كلمة المحقّقين من علمائنا إلى قولٍ واحد ، خلاصته : إنّ المبدوء به في أوائل أسانيد الكافي بهذا العنوان المطلق «محمّد بن إسماعيل» هو النيسابوري لا غير(4).
ص: 47
قال النجاشي:
محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي، أبو الحسين الكوفي، ساكن الري، يقال له: محمّد بن أبي عبد اللّه، كان ثقة، صحيح الحديث، إلاّ أنّه روى عن الضعفاء، وكان يقول بالجبر والتشبيه - وكان أبوه وجهاً...(1).
وقال الشيخ في آخر التوقيعات الواردة على أقوام ثقات:
ومات الأسدي على ظاهر العدالة، لم يتغيّر، ولم يطعن عليه، في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثلاثمئة(2).
وترضّى عليه الشيخ الصدوق، وقدّم مايرويه على غيره في صورة التعارض.
هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسن، أبو العبّاس، القرشي، الرزّاز، ثقة جليل، من أجلاّء ومشاهير مشايخ الكليني. وذكر أبو غالب الزُّرَاري في رسالته الشهيرة ما يدلّ بكلّ وضوح على جلالة الرزّاز، وسموّ قدره، ومنزلته بين صفوف الشيعة في عصره(3).
وقد وقع في أسانيد الكافي بعدّة عناوين، هي: أبو العبّاس الرزّاز، وأبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر، ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفي، ومحمّد بن جعفر الرزّاز، ومحمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي، ومحمّد بن جعفر، وأبو العبّاس الكوفي . والمقصود من جميعها واحد ، إلاّ في الأخيرين ؛ لكونهما من المشتركات ما لم تكن قرينة دالّة على إرادة الرزّاز.
ص: 48
قال النجاشي:
محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار ... أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القمّيين، ثقة، عظيم القدر، راجحاً، قليل السقط في الرواية - إلى أن قال : - توفّي محمّد بن الحسن الصفّار بقمّ، سنة تسعين ومئتين رحمه اللّه (1).
وعَدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام العسكري عليه السلام ، قائلاً:
له إليه عليه السلام مسائل، يلقّب: ممولة(2).
وقد أكثر الصدوق من الرواية عنه بتوسّط شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه .
من مشايخ الكليني، وليس له في الكافي رواية - بهذا العنوان - ، ولا في غيره من كتب الحديث. نعم روى الكليني كتب علي بن العبّاس الجراذيني الرازي بواسطته(3). ولهذا عدّه الشيخ آقا بزرك من مشايخ ثقة الإسلام الكليني(4).
روى عنه ثقة الإسلام حديثا واحدا فقط(5) ، وهو مهمل لم يذكره أحد ، وليس له في الكتب الأربعة سوى هذا الحديث.
من أجلاّء مشايخ الكليني قدس سره، قال النجاشي:
ص: 49
كان ثقة وجهاً، كاتب صاحب الأمر عليه السلام ، وسأله مسائل في أبواب الشريعة(1).
وهو من مشايخ ابن قولويه أيضاً. وهو من رجال عِدّة الكافي الذين يروي الكليني
عنهم، عن البرقي.
من مشايخ ثقة الإسلام(2)، روى عنه في فروع الكافي(3)، وهو من رجال عِدّة الكافي الذين يروي بتوسّطهم عن سهل بن زياد، كما صرّح بهذا العلاّمة الحلّي.
من شيوخ الكليني، حدّث عنه ببعلبك، قال ابن عساكر في ترجمة الكليني:
قدم دمشق، وحدّث ببعلبك، عن أبي الحسين محمّد بن علي الجعفري السمرقندي...(4).
وليس له ذكر في الكافي، ولم يقع في إسناد الحديث الشيعي، ولم يذكره سوى ابن عساكر.
المفضل الشيباني(1)، كما روى عنه فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي صاحب التفسير(2).
من مشايخ الكليني رضى الله عنه، روى عنه خطبة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام بعد موت النبيّ صلى الله عليه و آله بسبعة أيّام، وذلك حين فرغ من جمع القرآن الكريم، كما في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق(3). وليس له رواية في الكافي .
من مشايخ الكليني، روى عنه في الكافي حديثا واحدا، بلفظ: «حدّثني» ؛ فقال بعد نقله حديثاً: «وحدّثني به محمّد بن محمود، أبو عبداللّه القزويني»(4). وليس لمحمّد هذا غير هذا الحديث، كما ليس له ذكر في كتب الرجال.
من أجلاّء مشايخ الكليني، قال النجاشي:
محمّد بن يحيى، أبو جعفر العطّار القمّي ، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث ...(5).
وأشهر تلامذة محمّد بن يحيى ثلاثة، هم: ثقة الإسلام الكليني ، وقد أكثر من الرواية عنه في جميع أبواب الكافي ، والصدوق الأوّل، ومحمّد بن الحسن بن الوليد القمّيين.
ص: 51
وهو من رجال عِدّة الكافي الذين روى عنهم الكليني عن الأشعري والبرقي.
من مشايخ الكليني، روى عنه في الكافي حديثا واحدا. ولم يذكره أحد من الرجاليين.
هو أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي، من مشايخ الكليني، قال الطبري الصغير في دلائل الإمامة:
وعنه (يعني: أبا المفضّل الشيباني) قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني قدّس
سرّه، قال: حدّثني أبو حامد المراغي(1).
وروى الكشّي بسنده عن أبي جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمّي العطّار توقيعا شريفا للإمام الحجّة عليه السلام يدلّ على جلالة وعلوّ منزلة أبي حامد المراغي(2).
من مشايخ الكليني، ذكره في أوائل أسانيد الكافي، مبتدئا به ثمان مرّات مستقلاًّ ، كما اشترك في ستّة موارد أُخرى مع (عِدّة الكافي) في النقل عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد.
روى الكليني في الكافي عن مجموعة من مشايخه، معبّرا عنهم بلفظ «عِدّة من أصحابنا»، روايات كثيرة بلغت - بإحصائنا - ثلاثة آلاف وحديثين. ويمكن تقسيم هذه العِدّة - بلحاظ من روت عنه - إلى طائفتين، هما:
ص: 52
ورجال هذه العِدّة خمسة، وكلّهم من القمّيين، وهم بحسب الترتيب:
أ . أحمد بن إدريس، أبو علي الأشعري القمّي .
ب . داوود بن كُورة القمّي .
ج . علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي .
د . علي بن موسى الكُمنداني - بالنون والدال المهملة - القمّي .
ه- . محمّد بن يحيى العطّار القمّي .
ورجال هذه العِدّة سبعة، ستّة من أهل قمّ، وواحد مشترك بين كوفِيَّيْن، وهم:
أ . أحمد بن عبداللّه القمّي .
ب . علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي .
ج . علي بن الحسين السعدآبادي، أبو الحسن القمّي .
د . علي بن محمّد بن عبداللّه القمّي، يُعرف بماجيلويه، وهو ابن بنت البرقي، ويقال له: محمّد بن علي بن بُندار.
ه- . محمّد بن جعفر، وهو مشترك بين أبي الحسين الأسدي الكوفي ساكن الري، وبين أبي العبّاس الرزّاز الكوفي، خال أبي غالب الزُّرَاري الثقة المشهور .
و . محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحِميَري القمّي .
ز . محمّد بن يحيى العطّار القمّي .
ورجال هذه العِدّة أربعة، فيهم قمّي، وكلينيّان رازيان، وكوفي ساكن الريّ، وهم:
ص: 53
أ . علي بن محمّد بن علاّن الكليني الرازي.
ب . محمّد بن أبي عبداللّه (وهو محمّد بن جعفر الأسدي الكوفي نزيل الري).
ج . محمّد بن الحسن الصفّار القمّي.
د . محمّد بن عقيل الكليني الرازي.
وهي سبع عِدَدٍ فقط، وقعت في إسناد ثمانية أحاديث، كالآتي:
1 - «عِدّة من أصحابنا، عن عبداللّه بن البزاز»(1).
2 - «عِدّة من أصحابنا، عن جعفر بن محمّد»(2).
3 - «عِدّة من أصحابنا، عن سعد بن عبداللّه»(3).
4 - «عِدّة من أصحابنا، عن الحسين بن الحسن بن يزيد»(4).
5 - «عِدّة من أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر»(5).
6 - «عِدّة من أصحابنا، عن صالح بن أبي حمّاد»(6).
7 - «عِدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عيسى»(7).
هذه هي الطائفة الثانية من عِدَد الكافي، ولم أجد فيه - بعد الفحص والتحرّي الدقيق - بعض العِدَد التي ذكرها صاحب الكليني والكافي ونسبها للكافي، كعدّته عن علي بن الحسن بن فضّال، وعِدّته عن محمّد بن عبداللّه ماجيلويه(8).
ص: 54
تتلمذ على يد الشيخ الكليني رحمه الله عدد كثير من أعلام الشيعة وغيرهم، وقد أحصينا أكثر من ثلاثين رجلاً منهم، هم:
من مشاهير تلاميذ الكليني، وأجازه رواية ما سمعه منه من مصنّفات وأحاديث(1)، وعدّه ابن عساكر في تاريخ دمشق من جملة من روى عن الكليني(2)، ومثله ابن ماكولا(3).
من تلاميذ الكليني، ومن جملة رواة الكافي عنه، قال النجاشي في ترجمة الكليني:
كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي أقرأ القرآن على صاحب المسجد، وجماعة من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب، حدّثكم محمّد بن يعقوب الكليني. ورأيت أبا الحسن العقراني يرويه عنه(4).
من تلاميذ الكليني(5)، نقل السيّد هاشم البحراني من كتاب عيون المعجزات ما يدلّ على كون صاحب العنوان من تلامذة الكليني؛ إذ قال ما هذا لفظه:
السيد المرتضى في عيون المعجزات، قال: حدّثنا أبو الحسن أحمد بن الحسين
ص: 55
العطار، قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن يعقوب صاحب كتاب الكافي...(1).
قال الشيخ في بيان طرقه إلى كتب ثقة الإسلام الكليني:
وأخبرنا السيّد الأجل المرتضى رضى الله عنه، عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن الكليني(2).
من معاصري الشيخ الصدوق وابن قولويه، وأساتذة الشيخ المفيد، وابن الغضائري، وابن عبدون، ومن تلاميذ الكليني رحمهم اللّه. قال الكراجكي في الاستنصار :
أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد جميعا؛ عن محمّد بن يعقوب ...(3).
وبهذا يظهر اتّحاد صاحب العنوان مع أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي.
من تلاميذ الكليني، ومن رواة كتاب الكافي عن مصنّفه، صرّح بهذا النجاشي في ترجمته قائلاً:
إسحاق بن الحسن بن بكران العقرائي التمّار، كثير السماع، ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت علوّا فلم أسمع منه شيئا(1).
وقال في ترجمة الكليني عند ذكر الكافي:
ورأيت أبا الحسن العقراني يرويه عنه(2).
من أجلاّء تلامذة الكليني، روى عنه كثيرا في كتابه المشهور (كامل الزيارات)(3).
وقد تتلمذ الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه رضى الله عنه على مجموعة من المشايخ الأجلاّء ويأتي في مقدّمتهم: أبوه الثقة الجليل الشيخ محمّد بن قولويه، والشيخ ثقة الإسلام الكليني، ومحمّد بن عبداللّه بن جعفر الحِميَري، وغيرهم(4). ومات رحمه الله ببغداد، ودُفن في مقابر قريش إلى جوار مرقد الإمام الكاظم عليه السلام .
من مشايخ الصدوق وتلاميذ الكليني، ويدلّ عليه ما رواه الصدوق عن خمسة من
ص: 57
مشايخه ، وكان أبو محمّد الحسن بن أحمد المؤدّب من جملتهم، قالوا: «حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني»(1). وروى أيضا عن مجموعة من مشايخه - وفيهم المؤدّب هذا - قالوا: «حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله »(2).
من مشايخ الصدوق وتلاميذ الكليني ، كما يظهر من قول الشيخ الصدوق:
حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، وعلي بن أحمد بن محمّد بن عمران
الدقّاق، وعلي بن عبداللّه الورّاق، والحسن ابن أحمد المؤدّب، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب رضي اللّه عنهم؛ قالوا: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني(3).
قال الشيخ الطوسي في أماليه:
أخبرنا الحسين بن عبيداللّه ... حدّثنا الحسين بن صالح بن شعيب الجوهري، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني ...(4).
ذكره ابن عساكر في ترجمة الكليني قائلاً:
روى عنه : أبو سعد الكوفي ... وعبداللّه بن محمّد بن ذكوان(5).
وليس لعبداللّه هذا أيّ حديث في كتبنا، ولم يذكره أحد من علماء الإمامية، وإنّما هو من رجال العامّة.
ص: 58
هو أحد رواة الكافي عن مصنّفه، وكان مع الكليني ببغداد وأخذ منه جميع مصنّفاته وأحاديثه سماعا وإجازة سنة (327 ه ).
وذكره الشيخ الطوسي في بيان طريقه إلى ما رواه عن الكليني من مشيخة التهذيب(1).
عدّه الشيخ الطهراني من مشايخ الصدوق وتلامذة الكليني، ونقل عن إكمال الدين قول الشيخ الصدوق:
حدّثنا علي بن أحمد الرازي، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب ...(2).
من مشايخ الشيخ الصدوق، روى عنه، عن ثقة الإسلام الكليني(3).
ويظهر من رواياته في كتب الصدوق أنّه يروي عن مجموعة من المشايخ منهم الكليني، وحمزة بن القاسم العلوي، وأبي العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، وغيرهم.
عدّه جماعة من العلماء من تلامذة الكليني(4)، وهو من مشايخ الشيخ الصدوق.
ص: 59
عدّه الشيخ أقا بزرك الطهراني رحمه الله من تلامذة الكليني، بل من رواة كتاب الكافي عن مصنّفه(1). وهو من مشايخ الشيخ الصدوق، وروى عنه في سائر كتبه . ويظهر من بعض رواياته عكوفه الطويل على الحديث الشريف وروايته.
ليس له رواية في كتب الحديث الشيعي إلاّ رواية واحدة فقط، وهو من رجال العامّة ورواتهم ، ذكره ابن عساكر في ترجمة الكليني قائلاً:
روى عنه أبو سعد الكوفي ... وأبو القاسم علي بن محمّد بن عبدوس الكوفي(2).
هو من تلامذة الكليني ومن المقرّبين إليه، ومن جملة من استنسخ الكافي عن
نسخة مؤلّفه. وله رحلة واسعة في طلب الحديث، وهو من كبار محدّثي الشيعة الإمامية بلا خلاف، ومن تراثه الخالد: كتاب الغيبة، وحدّث فيه عن شيخه الكليني كثيرا.
من تلاميذ ثقة الإسلام الكليني وأحد رواة كتاب الكافي(3)، ذكره الشيخ في الفهرست قائلاً:
محمّد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب، يكنّى أبا الحسن، وقال أحمد بن عبدون: هو أبو بكر الشافعي، مولده سنة إحدى وثمانين ومئتين بالحسينية، وكان يتفقّه على
ص: 60
مذهب الشافعي في الظاهر، ويرى رأي الشيعة الإمامية في الباطن، وكان فقيها على المذهبين، وله على المذهبين كتب ...(1).
قال السيّد ابن طاووس قدس سره:
حدّث أبو نصر محمّد بن أحمد بن حمدون الواسطي، قال: حدّثنا: محمّد بن يعقوب الكليني ...(2).
وأورده العلاّمة المجلسي في البحار عن فتح الأبواب، وفيه : «أحمد بن
أحمد بن علي بن سعيد الكوفي» بين الواسطي المذكور وبين الكليني(3)، ولعلّه هو الصحيح.
هو من تلاميذ الكليني، ويشهد لذلك ما رواه أبو القاسم علي بن محمّد الخزّاز القمّي بقوله:
...حدّثنا محمّد بن الحسين البزوفري بهذا الحديث ، يعني حديث زيد الشهيد في مشهد مولانا الحسين بن علي عليهماالسلام، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني...(1).
عدّه العلاّمة الطهراني من تلاميذ ثقة الإسلام الكليني(2)، ولم أجد له رواية عن ثقة الإسلام في كتب الحديث. كما لم أجد من ترجم له من علماء الرجال، بل لم أجد له ذكرا إلاّ عند الكراجكي، مع وقوع الاختلاف في ضبط اسم الرجل وكنيته في الموارد التي نقل فيها عنه.
رئيس المحدّثين، وشيخ الإمامية وفقيههم ومحدّثهم ومتكلّمهم في زمانه، ويكفي في وصفه ما ورد من كلمات بحقّه على لسان علماء العامّة، قال الذهبي :
ابن بابويه، رأس الإمامية، أبو جعفر، محمّد بن العلاّمة علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي ، صاحب التصانيف السائدة بين الرافضة، يضرب بحفظه المثل، يقال : له ثلاث مئة مصنّف ... وكان أبوه من كبارهم ومصنّفيهم(3).
قال الشيخ المفيد قدس سره:
أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، وأبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه جميعا؛ عن محمّد بن يعقوب الكليني ...(4).
ص: 62
وفي مزار ابن المشهدي خبرٌ يدلّ على ذلك أيضا، رواه العلاّمة النوري في مستدرك
الوسائل في باب استحباب الصلاة يوم عاشوراء وكيفيّها(1).
وبهذا يتبيّن اشتباه العلاّمة النوري في قوله بعدم رواية الشيخ الصدوق عن الكليني.
هو مشترك بين راويين، وكلاهما من مشايخ الصدوق ، هما:
الأوّل: محمّد بن علي بن محمّد بن أبي القاسم
ويدلّ عليه طريق النجاشي إلى رواية كتب «محمّد بن أبي القاسم»، حيث رواها عن أبيه علي بن أحمد، عن الشيخ الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه علي بن محمّد، عن أبيه محمّد بن أبي القاسم(2).
الثاني: محمّد بن علي بن أبي القاسم
ويدلّ عليه طريق الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه(3).
هذا، وقد روى الشيخ الصدوق في الخصال، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يعقوب الكليني(4). فهو إذن من تلامذة ثقة الإسلام، ولكنّه مشترك بين اثنين كما عرفت.
من رجالات الري، وأعلام كُلين، وهو من مشايخ الشيخ الصدوق ومن تلامذة الشيخ الكليني ، قال في مشيخة الفقيه :
ص: 63
وما كان فيه عن محمّد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه، فقد رويته عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى، ومحمّد بن أحمد السناني رضي اللّه عنهم، عن محمّد بن يعقوب الكليني. وكذلك جميع كتاب الكافي، فقد رويته عنهم، عنه(1).
من مشايخ الصدوق وتلاميذ الكليني، وقد أكثر الشيخ الصدوق من الرواية عنه في جميع كتبه ، ونقل المتوكّل إلى الشيخ الصدوق بعض الأحاديث التي سمعها من الكليني قدس سره(2).
من أعاظم المحدّثين وثقاتهم المشهورين، وله جلالة وذكر جميل بين علماء الرجال. روى كتاب الكافي عن الكليني كما في مشيخة التهذيب، والاستبصار، والفهرست(3) وروى عنه في غيرها أيضا(4).
روى عنه كبار علماء الإمامية ، كابن قولويه، والنعماني، والشيخ المفيد، والنجاشي.
روى عن ثقة الإسلام الكليني، قال السيّد ابن طاووس رضى الله عنه :
... ما روينا بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر الطبري، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني ...(5).
ص: 64
وهو من معاصري الكليني، ثقة، جليل القدر، له كتاب المسترشد في الإمامة، ويُعرف
بالطبري الكبير ؛ تمييزا له عن الطبري الصغير.
من تلاميذ الكليني، ذكره النجاشي عند ذكر مصنّفات أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، قائلاً:
وقال لي أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح: أخبرنا بها أبو الحسن بن داوود، عن محمّد بن اليعقوب...(1).
وقال في ترجمته:
شيخ هذه الطائفة وعالمها، وشيخ القمّيين في وقته، وفقيههم، حكى أبو عبداللّه
الحسين بن عبيداللّه أنّه لم يرَ أحدا أحفظ منه، ولا أفقه ولا أعرف بالحديث(2).
ويظهر من كلام النجاشي في ترجمته أنّه حدّث عن الكليني ببغداد؛ لأنّه قدمها واستقرّ بها إلى أن وافاه أجله ودفن بمقابر قريش (منطقة الكاظمية ببغداد حاليّا).
قال ابن عساكر في ترجمة الكليني:
قدم دمشق، وحدَّث ببعلبك ... روى عنه أبو سعد الكوفي شيخ الشريف المرتضى
أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي...(3).
هو الشيخ أحمد بن محمّد بن محمّد بن أبي طاهر سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين ابن سنسن، وُلِد سنة (285 ه )، ومات سنة (368 ه ).
ص: 65
عدّه العلاّمة النوري ممّن تلقّوا كتاب الكافي عن مصنّفه، ورووه عنه واستنسخوه ونشروه، وإلى نسخهم تنتهي نسخته(1) ، ويؤيّده ما قاله أبو غالب الزُّرَاري نفسه(2).
من مشاهير تلامذة الكليني والراوين كتاب الكافي عنه(3).
كان الكليني رحمه الله قليل التأليف - إذا ما قورن بغيره من علماء الإمامية كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد، والشيخ الطوسي - بسبب ما استغرقه الكافي من وقت طويل ، وممّا يؤسف له حقّا هو ضياع مؤلفّات الكليني ومصنّفاته سوى كتابه الكافي على الرغم من وصول بعضها إلى أزمانٍ متأخّرة.
المراد بالرؤيا، ما يراه النائم في نومه، أو الذي خمدت حواسّه الظاهرة بإغماء أو ما يشابهه(4)، وهي على ثلاثة أقسام: صادقة لا تحتاج إلى عناء أو جهد في التأويل، كرؤيا الأنبياء عليهم السلام. وصادقة أيضا ولكنّها بحاجة إلى تأويل. وكاذبة، وهي أضغاث أحلام.
وكتاب تعبير الرؤيا ذكره النجاشي من جملة كتب الكليني(5)، وسمّاه الشيخ الطوسي «كتاب تفسير الرؤيا»(6).
وممّا يكشف عن علم الكليني بتعبير الرؤيا وصحّة نسبة هذا الكتاب إليه، أنّه قد
ص: 66
روى أحاديث كثيرة في خصوص تعبير الرؤيا في روضة الكافي(1).
نشأت حركة القرامطة بعد منتصف القرن الثالث الهجري، وظهرت في الكوفة سنة (278 ه ) ثمّ سنة (286 ه )، وقد راح ضحيّة هجماتهم المتكرّرة على مدن العراق والحجاز ودمشق آلاف الضحايا الأبرياء، وبلغت قوّتهم في عصر الكليني رحمه الله أنّه لم يقدر على الوقوف بوجههم جيش مقاتل، ولم تصمد أمامهم مدينة محاربة. ومن جرائمهم الكبرى أنّهم اعتدوا على حرمة الكعبة المشرّفة سنة (317 ه ) ، فدخلوا الحرم المكّي الشريف، وقتلوا الحاج أثناء الطواف، وطرحوا القتلى في بئر زمزم، وعرّوا الكعبة المشرّفة من كسوتها، وقلعوا بابها، كما اقتلعوا الحجر الأسود وبقي عندهم أكثر من عشرين سنة في عاصمتهم هجر إلى أن رُدّ إلى مكانه بفضل الدولة الفاطمية بمصر.
وكانت للقرامطة آراء وعقائد فاسدة كثيرة، والكثير منها دال على كفرهم ومروقهم من الدين ، كما نصّ على هذا أصحاب المقالات والفرق ، كالأشعري والنوبختي وغيرهم(2).
كلّ هذا حمل علماء الإمامية للتصدّي إلى تلك الحركة قبل ظهورها بالكوفة ، كما يظهر من كتاب الفضل بن شاذان (ت 260 ه ) المعنون بكتاب الردّ على الباطنية
ص: 67
والقرامطة(1) ، والكليني المعاصر لتلك الحركة في تأليفه هذا الكتاب الذي نسبه إليه النجاشي(2) والشيخ الطوسي(3).
ذكره النجاشي في مؤلّفات الكليني(4)، وسمّاه الشيخ الطوسي بكتاب الرسائل(5) ، وصُحِّف في معالم العلماء إلى كتاب (الوسائل)(6).
وهذا الكتاب من الكتب المفقودة أيضا، وهو كما يبدو من اسمه خُصّص لجمع رسائل الأئمّة إلى أصحابهم أو أبنائهم عليهم السلام.
ونقل السيد ابن طاووس (ت 664 ه ) طرفا من هذا الكتاب مشيرا إليه صراحة حيثما ورد النقل منه. ويبدو أنّ السيد ابن طاووس كان متأثّرا بهذا الكتاب مفضّلاً له على ما كتب بهذا المجال .
والظاهر من كلام صدر المتألّهين الشيرازي (ت 1050 ه ) في شرح أُصول الكافي وصول الكتاب إلى عصره، حيث قال:
روى محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله في كتاب الرسائل بإسناده عن سنان بن طريف عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب هذه الخطبة إلى أكابر الصحابة وفيها كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله .. .(7).
وهو صريح في وصول كتاب الرسائل إلى عصره، ووقوفه عليه مع النقل المباشر
ص: 68
منه.
نسب النجاشي(1) والشيخ الطوسي(2) وسائر المتأخّرين هذا الكتاب إلى الكليني رحمه الله ، وهو من كتبه المفقودة أيضا، وهو علامة واضحة في معرفة الكليني قدس سرهبأحوال الرواة، وطبقاتهم، والتى يمكن تلمّس آثارها في مواقع كثيرة من الكافي نفسه .
من جملة من عدّ هذا الكتاب للكليني، هو النجاشي(3) وكفى بذلك إثباتا لصحّة نسبته إليه. وهذا الكتاب المفقود أيضا يشير بوضوح إلى عناية الكليني بالأدب العربي، وتلوّن ثقافته، ولو قُدِّر لهذا الكتاب البقاء لوقفنا على أسماء شعراء أهل البيت عليهم السلام، ولاطّلعنا من خلاله على غرر القصائد الشعرية التي قيلت في مدحهم عليهم السلام .
وهذا الكتاب لم تثبت - عندي - نسبته إلى الكليني رحمه الله ، ولم يذكر تلك النسبة أحد قط إلاّ السيّد عبدالعزيز الطباطبائي رحمه الله ، الذي ذكر هذا الكتاب وعدّه من مؤلّفات الكليني(4)، وأغلب الظن أنّه استنبطه من مكانٍ آخر وإن لم يُفصح عنه.
ومهما يكن فإنّ جميع ما ذكرناه من كتب الكليني مفقود، وقد اتّصل النقل المباشر من بعض تلك الكتب المفقودة إلى أزمان متأخّرة ، كرسائل الأئمّة عليهم السلام الذي بقي موجودا إلى القرن الحادي عشر الهجري، ثمّ فُقِد بعد ذلك، وربّما يكون في زوايا بعض المكتبات .
ص: 69
وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلّفات ثقة الإسلام، وهو موسوعة حديثية، فيه إلى جانب ما يلبّي حاجة الفقيه، والمحدّث، دقائق فريدة تتعلّق بشؤون العقيدة، وتهذيب السلوك، ومكارم الأخلاق. وقد رُزق هذا الكتاب فضيلة الشهرة في حياة مؤلّفه، فلا نظير له في بابه .
والمنهج المتّبع في الكافي للوصول إلى أُصول الشريعة وفروعها وآدابها وأخلاقها، إنّما هو بالاعتماد على حَمَلَة آثار النبوّة من نقلة حديث الآل عليهم السلام، الذي هو حديث الرسول صلى الله عليه و آله ، إذ صرّح أهل البيت عليهم السلام بأنّهم لا يحدّثون الناس إلاّ بما هو ثابت عندهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله ، وأنّهم كانوا يكنزونها كما يكنز الناس ذهبهم وورقهم، وأنّها كلّها تنتهي إلى مصدر واحد، وبإسناد واحد(1).
ومن ثمرات هذا التضييق في رواية السنّة المطهّرة في الكافي، وحصرها بذلك النمط من حملة الآثار، أنّك لا تجد بينهم للاُمويين وأذنابهم وأنصارهم وزنا ولا اعتبارا، ولا للخوارج والنواصب ورواتهم ذِكرا، ولا لمن لم يحفظ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله في أهل بيته عليهم السلام(2) عينا ولا أثرا(3). كما لا تجد فيه لمن نافق ممّن تسمّى بالصحابة ولصق بهم خبرا(4).
وهذا المنهج وإن كان هو المنهج العامّ عند محدّثي العترة، إلاّ أنّ شدّة التزام الكليني به مع ميزات كتابه الأُخرى هي التي حملت الشيخ المفيد قدس سره على القول: «بأنّ
ص: 70
الكافي من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة»(1)، كما حملت غيره على الإعجاب بكتاب الكافي والثناء على مؤلفه(2).
ومن هنا بذل علماء الشيعة - قديما وحديثا - جهودا علمية مضنية حول الكافي، فاستنسخوه كثيرا(3)، وشرحوا أحاديثه، وبيّنوا مشتركاته، ووضّحوا مسائله، واختصروه، وحقّقوا أسانيده، ورتّبوا أحاديثه، وصنّفوها على ضوء المصطلح الجديد، وترجموه إلى عدّة لغات، بحيث وصلت جهودهم حول الكافي إلى أكثر من مئتي كتاب. ومع كلّ هذه الجهود لم يقل أحد منهم بوجوب الاعتقاد والعمل بجميع ما بين دفّتيه، ولا ادُّعي إجماع على صحّة جميع ما فيه .
كما أنّ إعراض الفقهاء عن بعض مرويّات الكافي، لا يدلّ على عدم صحّتها عندهم، ولا ينافي كون الكافي من أجلّ كتبهم، إذ ربّ صحيح لم يُعمل به لمخالفته المشهور، وقد يكون وجه الإعراض لدليل آخر وعلّة أُخرى لا تقدح بصحّة الخبر.
قد تجد في الأوان الأخير من يخالف سيرة علماء الشيعة، ويتشبّث بحكاية عرض الكافي على الإمام المهدي عليه السلام ، ويستنصر لمقولة : «الكافي كافٍ لشيعتنا» بعد تلطيفها! وينسب للكليني رحمه الله على أثر ذلك أشياء لا دليل عليها، فتراه يجزم تارةً بأنّ للكليني صلاتٍ وتردّدا مع السفراء الأربعة رضي اللّه تعالى عنهم، ويؤكّد تارةً أخرى على أنّ كبار علماء الشيعة كانوا يأتون إلى الكليني ويسألونه وهو في مجالس سفراء الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف، وثالثة يتساءل: كيف لم يطلب أحد السفراء
ص: 71
من الكليني كتابه لعرضه على الإمام عليه السلام ؟
وجميع هذا الكلام باطل؛ أمّا عن الصِّلات والترّدد، فاعلم أنّه لا توجد للكليني رواية واحدة في الكافي عن أيٍّ من السفراء الأربعة (رضي اللّه تعالى عنهم) بلا واسطة، مع أنّه استقرّ ببغداد قبل سنة (310 ه )، وحدّث عن بعض مشايخ بغداد كما مرّ في مشايخه.
كما أنّ ثقة الإسلام لم يُكثر من الرواية عنهم بالواسطة، بل إنّ مروياتهم في الكتب الأربعة نادرة جدّا ، ولعلّها لا تزيد على عشرة أحاديث، منها حديثان فقط أخرجهما الكليني(1).
ولا ننسى في المقام دور أهل البيت عليهم السلام في كيفيّة توجيه رواة الحديث إلى الطرق الكفيلة بمعرفة الحديث الصحيح وتمييزه عن غيره بقواعد رصينة سار عليها علماء الشيعة إلى اليوم.
وأمّا ما ذُكر في المقام من دأب السفراء الأربعة (رضي اللّه عنهم) على متابعة الكتب والتأكّد من سلامتها! فهو كذب عليهم، مع المبالغة الظاهرة.
وأمّا عن الاستدلال على حكاية العرض، بالتوقيع الخارج من الناحية المقدّسة إلى الصدوق الأوّل (ت 329 ه )(2)، كما في الكليني والكافي(3) فلا ينبغي لأحد أن يصدّقه دليلاً، أو يتوهّمه شاهدا على صحّة احتمال عرض الكافي أو بعضه على الإمام المهدي عليه السلام بتوسّط أحد السفراء رضي اللّه عنهم؛ لاختلاف الموضوع بينهما اختلافا جذريا بحيث لا يمكن أن يُقاس أحدهما بالآخر.
ومما تقدّم يعلم أنّ الاغترار بحكاية «الكافي كافٍ لشيعتنا» وتصحيحها أو تلطيفها لا يستند إلى أيّ دليل علمي، بل جميع الأدلّة المتقدّمة قاضية ببطلان تلك الحكاية
ص: 72
التي لم يعرفها أحد ولا سمع بها أحد في أكثر من سبعة قرون بعد وفاة الكليني. ولا يستبعد أن يكون أصل الحكاية من اشتباهات بعض المشايخ المغمورين في زمان رواج المنهج الإخباري بحديث الشيخ الصدوق الذي أسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى «كهيعص» وأنّه قال عليه السلام : «الكاف: كاف لشيعتنا...»(1)، فانصرف ذهن المشتبه إلى كتاب الكافى¨، ثمّ نسب هذا للإمام المهدي عليه السلام بلحاظ أنّ الكليني لم يدرك
الإمام الصادق عليه السلام .
لعلماء الشيعة - قديما وحديثا - إزاء أحاديث الكافي ثلاثة مواقف، هي:
الموقف الأوّل: النظر إلى روايات الكافي سندا ودلالةً، والتعامل معها على أساس معطيات علمي الرجال والحديث دراية ورواية، وهذا هو رأي الأصوليين وأكثر العلماء والفقهاء والمحقّقين.
الموقف الثاني: الاطمئنان والوثوق بصحّة أحاديث الكافي ، بالمعنى المتعارف
عليه قبل تقسيم الأخبار إلى صحيح وحسن موثّق وضعيف، وهذا هو قول: الأخباريين الذي يمثل جانب الاعتدال بالقياس إلى الموقف الثالث .
الموقف الثالث: الحكم بقطعيّة صدور أحاديث الكافي عن المعصومين عليهم السلام، وهو قول الأسترآبادي، والخليل بن غازي القزويني، ومن وافقهم من الأخباريين، وهو شبيه بقول العامّة بشأن أحاديث البخاري ومسلم، ولا دليل عليه إلاّ بعض القرائن التي صرّح المحدّث النوري بأنّها لا تنهض بذلك.
اختلف المنهج السندي في كتاب الكافي اختلافا كلّيا عن المنهج السندي في كتاب
ص: 73
من لا يحضره الفقيه وكتابي التهذيب والاستبصار، إذْ سَلَكَ كلّ من المحمّدين الثلاثة طريقا يختلف عن الآخر في إسناد الأحاديث.
فحذف الصدوق أسانيد الأحاديث التي أخرجها في الفقيه للاختصار، ولم يُسند في متن الكتاب غير تسعة أحاديث فقط(1) بحسب ما استقرأناه. وقد استدرك على ما رواه بصورة التعليق بمشيخة في آخر الكتاب أوصل بها طرقه إلى أغلب مَنْ روى عنهم .
وأما الشيخ الطوسي فقد سلك في التهذيب والاستبصار تارةً مسلك الشيخ الكليني، واُخرى مسلك الشيخ الصدوق في الفقيه وذلك بحذف صدر السند والابتداء بمن نقل من كتابه أو أصله، مع الاستدراك في آخر الكتابين بمشيخةٍ.
وأما الكليني: فقد سلك في الكافي منهجا سنديا ينمُّ عن قابليّة نادرة وتتبّع واسع وعلمٍ غزير في متابعة طرق الروايات وتفصيل أسانيدها، إذْ التزم بذكر سلسلة سند الحديث إلاّ ما نَدَرَ، مع ملاحظة اُمور كثيرة في الإسناد.
منها: اختلاف طرق الرواية، فكثيرا ما تجده يروي الرواية الواحدة بأكثر من إسنادٍ . وقد يعدل أحيانا عن هذا المنهج عند توافر أكثر من طريق للرواية وذلك بذكر سند الطريق الأوّل ثمّ يعقبه بعد هذا بالطريق الثاني ذاكرا في نهايته عبارة «مثله» إشارة منه
إلى تطابق المتن في كلا الطريقين.
ومن الأُمور التي تلاحظ على منهجه السندي أنّه كثيراً ما يرد في أسانيد الكافي ذكر كُنى الرواة وبلدانهم وقبائلهم وحِرَفِهم .
وهناك مفردات أُخرى في المنهج السندي في كتاب الكافي نشير إلى بعضها اختصارا:
ص: 74
منها: الالتزام بالعنعنة في الإسناد كبديل مختصر عن صيغ الأداء الأُخرى.
ومنها: الأمانة العلميّة في التزام نقل ألفاظ مشايخ السند، ومن ذلك نقله لتردّد الرواة في التحديث عن مشايخهم بلفظ (حدّثني فلان، أو روى فلان)(1).
ومنها: اختصار سلسلة السند المتكرّر بعبارة: (وبهذا الاسناد)(2)، أو حذف تمام السند المتكرّر والاكتفاء بالعبارة المذكورة(3).
ومنها: تنوّع مصادر السند في الكافي، بحيث يمكن تصنيفها على طائفتين رئيسيّتين، هما: الرجال، والنساء الراويات، والرجال إلى معصومين وغيرهم، وهذا الغير إلى صحابة وتابعين وغيرهم، وقد جاءت مرويّاتهم لتتميم الفائدة، وبعضها الآخر لبيان وجه المقارنة بينها وبين مروياته الأُخرى. وأمّا النساء الراويات فقد بلغن ستّا وعشرين امرأة فيما تتبّعناه.
وهُناك بعض المصادر المجهولة في أسانيد الكافي(4).
ومنها: وجود الأحاديث الموقوفة(5)، والمرسلة(6)، والمجهولة ، وهي التي في إسنادها راوٍ لم يُسَمّ، وتسمّى المبهمة، وحكمها جميعا الإرسال، كما توجد فيه الأحاديث المضمرة(7)، مع توفّر بعض الأصناف الأُخرى لخبر الواحد المسند، كلّ صنف بلحاظ
ص: 75
عدد رواته تارةً - وهو ما ذكرناه آنفا - أو باعتبار حال رواته، أو بلحاظ اشتراك خبر الواحد المسند مع غيره كالمعنعن - كما مرّ - والمسلسل(1)، والمشترك(2)، والعالي، والنازل(3)، والمعلّق بشرط معرفة المحذوف.
ومنها: تعبير الكليني عن مجموعة من مشايخه بلفظ: «عدّة من أصحابنا» أو «جماعة من أصحابنا» والأوّل مطّرد، والآخر نادر.
يمكن تلخيص منهج الكليني في رواية متون الكافي بجملة من الأُمور، نذكر أهمّها:
1 - الإكثار من المتون الموشّحة بالآيات القرآنية، خصوصا آيات الأحكام، ولو استلّت تلك الروايات من الكافي لألّفَتْ تفسيرا رائعا لأهل البيت عليهم السلام في أحكام القرآن الكريم.
2 - اشتمال بعض متون الكافي على توضيحات من الكليني(4).
3 - بيان موقفه أحيانا من تعارض مرويّاته(5) وربّما نبّه إلى ما خالف الإجماع على الرغم من صحّته بطريق الرواية(6).
4 - رواية ما زاد على المتن من ألفاظ الرواة؛ لفرط أمانته في نقل الخبر ، وهذا ما
ص: 76
يُسمّى اصطلاحا بمدرج المتن(1).
5 - الاقتباس والرواية من الكتب كالأُصول الأربعمئة وغيرها.
6 - ترك الكثير من الأخبار التي لم يرها قابلةً للرواية.
7 - تصنيف الأحاديث في الأبواب بحسب الصحّة والوضوح، ولذلك فإنّ أحاديث أواخر الأبواب - كما قاله بعض المحقّقين - لا تخلو من إجمال وخفاء(2).
8 - رواية القواعد الأساسيّة في دراية الحديث وروايته وتقديمها في اُصول الكافي .
10 - لا يورد الأخبار المتعارضة، بل يقتصر على ما يدلّ على الباب الّذي عنونه، وربّما دلّ ذلك على ترجيحه لما ذكر(3).
11 - اهتمامه البالغ في رواية المشهور والمتواتر ، خصوصا في أُصول الكافي
وفروعه.
12 - العناية الفائقة برواية ما يتّصل بمكانة أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم وعلمهم وإمامتهم والنصّ عليهم.
13 - إخضاع متون الكافي أُصولاً وفروعا إلى تبويب واحد، دون روضة الكافي .
لتصنيف الأحايث الشريفة وتبويبها وترتيبها طريقتان مشهورتان، هما:
1 - طريقة الأبواب: وفيها يتمّ توزيع الأحاديث على مجموعة من الكتب،
ص: 77
والكتب على مجموعة من الأبواب، والأبواب على عدد من الأحاديث، بشرط أن تكون الأحاديث مناسبةً لأبوابها، والأبواب لكتبها. وقد سبق الشيعةُ غيرَهم إلى استخدام هذه الطريقة.
2 - طريقة المسانيد: التصنيف بموجب هذه الطريقة له صور متعدّدة؛ الجامع بينها هو أن يكون المحور في الترتيب هو الرواة أو المروي عنه .
وقد استخدم الكليني قدس سره الطريقة الأُولى في تصنيف كتابه الكافي، لتلبيتها غرضه في أن يكون كتابه مرجعا للعالِم والمتعلّم. وقد حقّق ثقة الإسلام هذا المطلب على أحسن ما يُرام، إذْ قسّم كتابه الكافي على ثلاثة أقسام رئيسيّة، هي: اُصول الكافي، وفروع الكافي، وروضة الكافي .
ثمّ قسّم أُصول الكافي على ثمانية كتب اشتملت على (499) بابا ، وتجد هذا التصنيف نفسه في فروع الكافي أيضا، إذ اشتملت على (26) كتابا، فيها (1744) بابا. أمّا روضة الكافي فلم يخضعه إلى هذا المنهج من التصنيف، بل ساق أحاديثه تباعا من غير كتب أو أبواب.
هذا وقد أثار الخليل بن غازي القزويني - في المحكي عنه - شبهة حول نسبة الروضة للكليني، فقال في رياض العلماء في ترجمته: «ومن أغرب أقواله: ... وأنّ الروضة ليس من تأليف الكليني رحمه الله ، بل هو من تأليف ابن إدريس»(1).
وجوابها هو أنّ الملحوظ على كتاب الروضة جملة أُمور ، منها:
1 - أُسلوب عرض المرويّات فيه هو الأُسلوب بذاته في أُصول وفروع الكافي ، إذ يبدأ أوّلاً بذكر سلسلة السند كاملة إلاّ ما ندر ، ومن ثمّ اتّباع أُسلوب البحث عن طرق
أُخرى مكمّلة للرواية وترتيب هذه الطرق بحسب جودتها، وهذا هو ما عُمل في أُصول وفروع الكافي .
ص: 78
2 - لغة الروضة من حيث العنعنة السائدة، والاصطلاح المتداول في نظام الإحالة على إسناد سابق، واختصار الأسانيد، والمتابعات والشواهد ، هي بعينها في أُصول الكافي وفروعه.
3 - رجال أوّل السند من مشايخ الكليني إلاّ القليل النادر منهم حيث أخذ مرويّاتهم من كتبهم المتداولة في عصره والمعروفة الانتساب إلى أصحابها الثقات .
4 - طرق روايات الأُصول والفروع إلى أصحاب الأئمّة عليهم السلام هي طرق روايات الروضة أيضا.
5 - روايات العِدَّة التي يروي بتوسّطها عن ثلاثة من المشايخ المعروفين توزّعت على الأُصول والفروع والروضة ، وليس لهذه العِدّة أثر في كتب الحديث الأُخرى .
6 - هناك جملة وافرة من مرويّات الروضة مرتبطة بعناوين بعض كتبه المفقودة، كروايات تعبير الرؤيا المرتبطة بكتاب تعبير الرؤيا المفقود، وروايات رسائل الأئمّة عليهم السلامالمرتبطة بكتاب الرسائل المفقود أيضا. وهذا ما يقرب من احتمال نقلها من كتبه المذكورة إلى كتاب الروضة، لاسيّما وأنّ الكافي آخر مؤلفّات الكليني(1).
مع تصريح المتقدّمين بأنّ الروضة من كتب الكافي ، فقال النجاشي في ترجمة الكليني:
صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي في عشرين سنة، شرح كتبه: كتاب العقل، كتاب فضل العلم - إلى أن قال - كتاب الروضة(2).
ونظير ذلك ما قاله الشيخ(3).
ص: 79
هذا وقد ذكر الشيخ الكليني في الروضة أمورا شتّى من خطب الأئمّة عليهم السلام ورسائلهم وحكمهم ومواعظهم، مع تفسير عدد كبير من الآيات القرآنية الكريمة، كما تضمّن نتفا من الأحداث التاريخية المهمّة، وسير بعض الصحابة وكيفيّة إسلامهم.
ويبدو للباحث أنّ هذا الجزء الحافل بمختلف الأخبار من عقائد وتفسير وأخلاق وقصص وتاريخ وجغرافية وطبّ وفلك ، جاء اسما على مسمّاه، فهو كالروضة الندية حقّاً .
ما قاله العلماء من كلمات الثناء العاطر على شخصيّة الكليني ودوره العلمي والثقافي تدلّ على مكانته المرموقة التي قلّما وصل إليها الأفذاذ، ولم ينحصر هذا الثناء بعلماء الشيعة، بل أطراه علماء العامّة، بل والمستشرقون أيضاً . إليك فيما يلي بعضها:
1 - تلميذه الشيخ الصدوق (ت 381 ه ) قال:
حدّثنا الشيخ الفقيه محمّد بن يعقوب رضي اللّه عنه(1).
2 - النجاشي (ت 450 ه ) قال في ترجمته:
شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث، وأثبتهم ...(2).
3 - الشيخ الطوسي (ت 460 ه ) قال في الفهرست :
ثقة، عارف بالأخبار(3).
ص: 80
وقال في الرجال :
جليل القدر، عالم بالأخبار(1).
4 - العلاّمة الطبرسي (ت 548 ه ) قال في ذكر الدلالة على إمامة الحسن بن علي عليه السلام :
فمن ذلك: ما رواه محمّد بن يعقوب الكليني وهو من أجلّ رواة الشيعة وثقاتها(2).
5 - السيّد ابن طاووس الحلّي الحسني (ت 664 ه ) قال في فرج المهموم :
الشيخ المتّفق على عدالته وفضله وأمانته محمّد بن يعقوب الكليني(3).
6 - العلاّمة الحلّي (ت 726 ه ) قال :
شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم(4).
7 - المحقّق الكركي (ت 940 ه ) قال في إجازته للشيخ أحمد بن أبي جامع:
وأعظم الأشياخ في تلك الطبقة الشيخ الأجلّ جامع أحاديث أهل البيت
عليهم السلام صاحب كتاب الكافي في الحديث، الذي لم يعمل الأصحاب مثله(5).
8 - الشهيد الثاني (ت 966 ه ) قال في إجازته للسيّد علي بن الصائغ الحسيني الموسوي:
عن الشيخ السعيد الجليل رئيس المذهب أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني، عن
رجاله المتضمّنة لكتابه الكافي ، الذي لا يوجد في الدنيا مثله جمعا للأحاديث وتهذيبا للأبواب، وترتيبا، صنّفه في عشرين سنة، شكر اللّه تعالى سعيه، وأجزل أجره، عن رجاله المودعة بكتابه وأسانيده، المثبتة فيه بشرطه المعتبر عند أهل دراية الأثر(6).
9 - الشيخ حسين بن عبدالصمد (ت 984 ه ) قال في وصول الأخيار :
ص: 81
أمّا كتاب الكافى¨، فهو للشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه شيخ عصره في وقته، ووجه العلماء والنبلاء، وكان أوثق الناس في الحديث، وأنقدهم له، وأعرفهم به، صنّف الكافي وهذّبه وبوّبه في عشرين سنة، وهو يشتمل على ثلاثين كتابا يحتوي على ما لا يحتوي غيره(1).
10 - الشهيد الثالث القاضي نور اللّه التستري (ت 1019 ه ) قال في مجالس المؤمنين :
ثقة الإسلام، وواحد الأعلام خصوصا في الحديث، فإنّه جهينة الأخبار، وسابق هذا المضمار، الذي لا يُشقّ له غبار، ولا يُعثر له على عِثار(2).
11 - المحقّق الداماد (ت 1041 ه ): قال في الرواشح:
وإن كتاب الكافي لشيخ الدين، وأمين الإسلام، نبيه الفرقة، ووجيه الطائفة، رئيس المحدّثين، حجّة الفقه والعلم والحقّ واليقين، أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني رفع اللّه درجته في الصديقين، وألحقه بنبيّه وأئمّته الطاهرين(3).
12 - صدر المتألّهين محمّد بن إبراهيم الشيرازي (ت 1050 ه ) قال في شرح أُصول الكافي :
أمين الإسلام، وثقة الأنام، الشيخ العالم الكامل، والمجتهد البارع، الفاضل محمّد بن يعقوب الكليني، أعلى اللّه قدره، وأنار في سماء العلم بدره(4).
13 - العلاّمة المجلسي (ت 1111 ه ) قال في مرآة العقول :
وابتدأت بكتاب الكافي للشيخ الصدوق، ثقة الإسلام، مقبول طوائف الأنام، ممدوح الخاصّ والعامّ، محمّد بن يعقوب الكليني، حشره اللّه مع الأئمّة الكرام؛ لأنّه كان أضبط الأُصول وأجمعها، وأحسن مؤلّفات الفرقة الناجية وأعظمها(5).
14 - السيّد بحر العلوم (ت 1212 ه ) قال :
ص: 82
محمّد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني، ثقة الإسلام، وشيخ المشايخ الأعلام، ومروّج المذهب في غيبة الإمام عليه السلام ذكره أصحابنا والمخالفون، واتّفقوا على فضله، وعظم منزلته(1).
15 - السيّد محمّد باقر الخوانساري (ت 1313 ه ) قال بعد بيان مَن مدحه من علماء العامّة - :
وبالجملة فشأن الرجل أجلّ وأعظم من أن يختفي على أعيان الفريقين، أو يكتسي ثوب الإجمال لدى ذي عينين، أو ينتفي أثر إشراقه يوما بعد البين؛ إذ هو في الحقيقة أمين الإسلام، وفي الطريقة دليل الأعلام، وفي الشريعة جليل قدّام، ليس في وثاقته لأحد كلام، ولا في مكانته عند أئمّة الأنام، وحسب الدلالة على اختصاصه بمزيد الفضل، وإتقان الأمر، اتّفاق الطائفة على كونه أوثق المحمّدين الثلاثة الذين هم أصحاب الكتب الأربعة، ورؤساء هذه الشرعة المتَّبَعَة(2).
16 - المحدّث النوري (ت 1320 ه ) قال في خاتمة المستدرك :
فخر الشيعة، وتاج الشريعة، ثقة الإسلام، وكهف العلماء الأعلام، أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني... الرازي، الشيخ الجليل، العظيم، الكافل لأيتام آل محمّد عليهم السلام بكتابه الكافي(3).
17 - الشيخ عبّاس القمّي (ت 1359 ه ) قال:
الشيخ الأجل، الأوثق، الأثبت، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي، كهف العلماء الأعلام، ومفتي طوائف الإسلام، ومروِّج المذهب في غيبة الإمام عليه السلام ثقة الإسلام، صاحب كتاب الكافي(4).
18 - الإمام الخميني قدس سره (ت 1409 ه ) وصف الكليني رحمه الله بأوصاف منها :
أفضل المحدّثين ، إمامهم ، ثقة الإسلام والمسلمين ، حجّة الفرقة ، رئيس الأُمّة،
ص: 83
ركن الإسلام وثقته، سلطان المحدّثين، شيخ المحدّثين وأفضلهم ، عماد الإسلام
والمسلمين، فخر الطائفة الحقّة ومقدّمهم(1).
1 - أبو السعادات مبارك بن محمّد بن الأثير الجزري (ت 606 ه ): قال في جامع الأُصول :
أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازي الفقيه الإمام على مذهب أهل البيت [عليهم السلام]، عالم في مذهبهم، كبير، فاضل عندهم، مشهور(2).
كما ذكر حديث المجدّدين، وجعل الكليني قدس سرهمن المجدّدين على رأس المئة الثالثة، فقال:
ومن خواصّ الشيعة أنّ لهم على رأس كلّ مئة سنة من يجدّد مذهبهم ، وكان مجدّده على رأس المئتين علي بن موسى الرضا[ عليهماالسلام] وعلى المئة الثالثة محمّد بن يعقوب(3).
2 - الذهبي، أبو عبداللّه محمّد بن أحمد (ت 748 ه ): قال:
محمّد بن يعقوب الكليني، من رؤوس فضلاء الشيعة في أيّام المقتدر(4).
وقال في تاريخ الإسلام :
محمّد بن يعقوب، أبو جعفر الكليني الرازي: شيخ، فاضلٌ، شهيرٌ، من رؤوس الشيعة وفقهائهم المصنّفين(5).
3 - ابن ناصر الدين محمّد بن عبداللّه بن محمّد القيسي (ت 842 ه ) نقل كلام الذهبي في المشتبه في خصوص الإطراء على الكليني ووافقه(6).
ص: 84
4 - ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (ت 852 ه ) قال في التبصير :
وأبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي، من فقهاء الشيعة، ومصنّفيهم، يُعرف
بالسلسلي ؛ لنزوله درب السلسلة ببغداد(1).
5 - الزَّبِيدي الحنفي (ت 1205 ه ) قال في تاج العروس في مادّة (كلان) :
كلين... بلدة بالري، منها: أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني، من فقهاء الشيعة، ورؤوس فضلائهم في أيّام المقتدر، ويُعرف أيضا بالسلسلي؛ لنزوله درب السلسلة ببغداد(2).
6 - الزركلي الوهابي (ت 1396 ه ) قال:
محمّد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني، فقيه إمامي، من أهل كلين بالريّ، كان شيخ الشيعة ببغداد وتوفّي فيها(3).
7 - عمر رضا كحالة قال في معجم المؤلّفين:
محمّد بن يعقوب بن إسحاق، الكليني الرازي، السلسلي، البغدادي، أبو جعفر، من فقهاء الشيعة، عارف بالأخبار، والحديث، سكن بغداد بباب الكوفة، وتوفّي ببغداد(4).
8 - المستشار عبدالحليم الجندي قال عند كلامه عن الأُصول الأربعمئة في الحديث:
وخير ما جمع منها كتب أربعة، هي مرجع الإمامية في أُصولهم وفروعهم إلى اليوم، وهي: الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار . والكافي للكليني أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني (ت 329 ه ) أعظمها، وأقومها، وأحسنها، وأتقنها، فيه: 16190 حديثا، ألّفه الكليني في عشرين سنة(5).
ص: 85
1 - قال Donaldisin Dawyt.M عن المحمّدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة (الكليني، والصدوق، والطوسي رضي اللّه تعالى عنهم):
وأوّل هؤلاء المحمّدين، وأعلاهم منزلة هو محمّد بن يعقوب الكليني الذي ألَّف كتاب الكافي في علم الدين(1).
2 - قال Karil Prokilman:
وفي أوائل القرن الرابع الهجري كان مجدّد فقه الإمامية هو أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكوليني [كذا] الرازي(2).
ص: 86
المحدّث الكليني وأثره الخالد
الشيخ جعفر السبحاني
محمّد بن يعقوب بن إسحاق ، ثقة الإسلام وشيخ المحدّثين أبو جعفر الكليني الرازي ، البغدادي ، صاحب كتاب الكافي أحد الكتب الأربعة عند الشيعة الإمامية.
ولد بعد منتصف القرن الثالث ، أي بعد عام 250 ه ، وتوفّي عام 329 ه .
إنّ للأُسرة الّتي يترعرع فيها الإنسان تأثيرا في تكوين شخصيته ونموّ سجاياه ورسم مؤهّلاته ، وقد ولد الشيخ الكليني في أُسرة علمية عريقة ، وتربّى في أحضانٍ فاضلة شريفة .
فوالده هو أحد علماء الري ، وقد انتقل إلى موطنه (كُلين) وبقي فيها إلى أن تُوفّي ، وقبره هناك معروف يُزار .
وأخوه إسحاق بن يعقوب أحد من يروي عنه الكليني على ما في غيبة الشيخ الطوسي، بإسناده عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، قال :
سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فوقع التوقيع بخطّ مولانا صاحب الدار عليه السلام : «أمّا ما سألت عنه - أرشدك اللّه تعالى وثبّتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا...»، وجاء في آخره : «والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب ، وعلى من اتّبع الهدى»(1) .
ص: 87
وأمّا أُمّه فهي أيضا من بيت عريق في العلم والحديث ، وكانت عالمة فاضلة ، تربّت في هذا البيت الّذي أنجب العديد من المحدّثين والعلماء .
فوالدها هو الشيخ محمّد بن إبراهيم بن أبان ، وصفه الشيخ الطوسي بقوله :
محمّد بن إبراهيم معروف بعلاّن الكليني ، خيّر(1) .
وعمّها هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أبان ، يعرّفه الشيخ الطوسي بقوله : أحمد بن إبراهيم المعروف بعلاّن الكليني ، خيّر ، فاضل من أهل الري(2) .
وأخوها هو الشيخ علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني ، يعرّفه النجاشي بقوله :
علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلاّن ، يُكنّى أبا الحسن ، ثقة ، عين ، له كتاب أخبار القائم عليه السلام (3) .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ «علاّن» لقب للعائلة ، حيث إنّ الجدّ والأب والخال يُطلق عليهم علاّن ، وخال الكليني هذا من مشايخه .
ويظهر من العلاّمة المامقاني أنّ ابن الخال محمّد بن علي وحفيده القاسم من محمّد كانا من علماء عصرهما(4) .
وهذا يدلّ على أنّ العلم قد ضرب بجرانه في هذه الأُسرة قبل الكليني وبعده ، وأنّه نشأ بين ظهرانيهم وتألّق نجمه عندهم ، فصار من أكابر المحدّثين وأعظم المجتهدين في عصره ، على وجهٍ أطلق لسان كلّ موافق ومخالف للثناء عليه وإطرائه .
إنّ البيئة الّتي عاش فيها الكليني كان يغلب عليها التشيّع ، فقد كانت الري وقمّ من
ص: 88
معاقل الشيعة ومراكز تجمّعهم.
ولكنّ الأفكار السائدة في العالم الإسلامي آنذاك ، كانت تميل إلى التجسيم والتشبيه وإثبات الجهة للّه سبحانه والقول بالجبر والقدر ، إلى غير ذلك ممّا طفحت به
كتب المحدّثين في ذلك العصر ، وذلك بعد أن مات المأمون والمعتصم اللذان كانا يؤيّدان التيّار العقلي ويحاربان تيّار المحدّثين الذين طغى عليهم الجمود ، ولمّا جاء المتوكّل ومن خَلَفه ، انقلبت سياسة البيت العبّاسي إلى تقريب أهل الحديث المتشدّدين وإقصاء أهل العقل والكلام ، وبهذا راجت الروايات المدسوسة من قبل مسلمة أهل الكتاب حول ما ذكرنا من أفكار وآراء .
كما ظهرت طوائف مختلفة ، فمن محدّث يحمل لواء التشبيه والتجسيم ويضمّ في جرابه كلّ غثّ وسمين لا يبالي عمّن أخذ وما أخذ ، إلى خارجي يكفّر جميع طوائف المسلمين بمل ء فمه ، ويحبّ الشيخين ويبغض الصهرين ، إلى دُخلاء في الإسلام يتظاهرون به صونا لدمائهم ويوجّهون سهام غدرهم إلى ظهور المسلمين ، إلى غير ذلك من الطوائف والأفكار المنحرفة الّتي نشأت بعد إقصاء العقل والعقليّين .
ويكفيك أنّ محمّد بن أبي إسحاق بن حُزَيمة (ت 311 ه ) ، كان من ثمرات ذلك العصر ، وقد ألّف كتابا أسماه التوحيد في إثبات صفات ربّ العالمين، وهو في الحقيقة كتاب شرك ، وقد قال عنه الرازي :
إنّه كان رجلاً مضطرب الكلام ، قليل الفهم ، ناقص العقل(1) .
وليس ابن حُزَيمة هو الوحيد في نشر التجسيم والتشبيه ، فقد سبقه في ذلك خُشَيش بن أصرَم (ت 525 ه ) مصنّف كتاب الاستقامة ، والّذي عرّفه الذهبي بأنّه : «يردّ فيه على أهل البدع»(2) . ويريد الذهبي ب «أهل البدع» أهل التنزيه الذين لا يُثبتون
ص: 89
للّه سبحانه خصائص الموجود الإمكاني وينزهّونه عن الجسم والجسمانية .
ولحقه أحمد بن محمّد السِّجِستاني السَّجزِي ، وقد اعتمد عليه الذهبي قائلاً :
بلغني أنّ ابن خزيمة حسن الرأي فيه ، وكفى بهذا فخرا(1) .
وكان لتلك الأفكار انتشار وصدى في الحواضر الإسلامية ، ولأجل نقد هذه المسائل ، عقد شيخنا الكليني في أُصول الكافي أبوابا وفصولاً عديدة لردّها وإبطالها.(2)
وكان أبو الحسن الأشعري (المعاصر للكليني) في أوّل أمره معتزليا رافعا لواء العقل والتفكير ، إلاّ أنّه رجع في عام 305 ه عن ذلك المنهج ، والتحق بمنهج الإمام أحمد مناديا بأعلى صوته في الجامع الكبير في البصرة : «من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أُعرّفه بنفسي ، أنا فلان بن فلان ، كنت قلتُ بخلق القرآن ، وأنّ اللّه لا يُرى بالأبصار ، وأنّ أفعال الشرّ أنا أفعلها ، وأنا تائب مقلع معتقد للردّ على
المعتزلة»(3) .
وهذا يشير إلى أنّ الجوّ العامّ في ذلك العصر لم يكن لصالح الداعين إلى التحرّر من الجمود والتقليد ، وإعمال الفكر والنظر .
لم يكن الشيخ الكليني متمكّنا من فنّ الحديث فحسب ، بل كان مع براعته فيه ، ملمّا بثقافة عصره ، مشاركا أو متخصّصا في أكثر من فرع من فروعها ، يظهر ذلك ممّا جاد به قلمه في كتبه العديدة .
فأدبه الراقي تبدو ملامحه من خلال مقدّمة الكافي وكذا من ثنايا هذا الكتاب ، كقوله :
ص: 90
الحمد للّه المحمود لنعمته ، المعبود لقدرته ، المطاع في سلطانه ، المرهوب لجلاله ، المرغوب إليه فيما عنده ، النافذ أمره في جميع خلقه ، علا فاستعلى ، ودنا فتعالى ، وارتفع فوق كلّ منظر ، الّذي لا بدء لأوّليته ، ولا غاية لأزليته(1) .
ومن ملامح أدبه - أيضا - أنّه أفرد كتابا فيما قيل في الأئمّة عليهم السلام من الشعر .
أمّا معرفته بالرجال فتبرز واضحة في الكافي ، حيث إنّ الأسانيد الّتي يسوقها قبل الرواية تعرب عن اطّلاعه الواسع على المشايخ والتلاميذ وطبقاتهم ، مضافا إلى أنّ له كتابا خاصّا في علم الرجال ، ذكره مترجموه ، إلاّ أنّه - للأسف - مفقود ، ولو وصلنا هذا الكتاب لنفعنا كثيرا .
هذا ولم تقتصر معرفة الكليني بالأدب والرجال ، وإنّما شملت علم الكلام أيضا ، حيث ذكر بعض آرائه الكلامية في ثنايا الأحاديث ، خصوصا في الجزء الأوّل .
أضف إلى أنّه ألّف كتابا في ردّ القرامطة أصحاب النحلة الفاسدة المنشقّة من الإسماعيلية .
إنّ أهمّ أثر تركه شيخنا المحدّث هو الكافي ، الّذي أمضى في تأليفه عشرين عاما من عمره الشريف ، ولذلك أصبح الكتاب من أوثق الكتب الحديثية ، وقد وصفه الشيخ المفيد بأنّه من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة(2) .
ويقول الشهيد في إجازته لابن الخازن :
كتاب الكافي في حديث ، الّذي لم يعمل الإمامية مثله(3) .
والمشهور أنّه يحتوي على 16199 حديثا ، وهو يزيد على ما في الصحاح الستّة من الأحاديث بعد حذف المكرّرات منها .
ص: 91
قد سمعت كلمة المفيد والشهيد في حقّ شيخنا المترجم ، وإليك كلمات أُخرى لعلماء الفريقين ، وسنقتصر على القليل بدل الكثير :
1 - قال النجاشي :
محمّد بن يعقوب بن إسحاق ، أبو جعفر الكليني ، شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، صنّف الكتاب الكبير المعروف الّذي يُسمّى الكافي في عشرين سنة(1) . ثمّ ذكر كتبه .
2 - وقال الشيخ الطوسي :
محمّد بن يعقوب الكليني يُكنّى أبا جعفر ، جليل القدر ، عالم بالأخبار ، وله مصنّفات يشتمل عليها الكتاب المعروف بالكافي(2) .
3 - وقال في الفهرست :
محمّد بن يعقوب الكليني ، يُكنّى أبا جعفر ، ثقة ، عارف بالأخبار ، له كتب، منها كتاب الكافي يشتمل على ثلاثين كتابا(3) .
هذا بعض ما قاله علماء الشيعة في حقّه ، وإليك بعض النصوص من علماء السنّة ، وقد ذكروه بإجلال من دون أيّ غمز فيه .
4 - ذكره مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمّد المعروف بابن الأثير (ت 606 ه ) في جامع الأُصول في تفسير ما رواه أبو هريرة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، أنّه قال :
«إنّ اللّه يبعث الأُمّة على رأس كلّ مئة سنة من يجدّد لها دينها» - وقال : أخرجه أبو داوود(4) .
ثمّ ذكر أنّ العلماء تكلّموا في تأويل هذا الحديث كلّ واحد في زمانه ، ثمّ قال :
ص: 92
ونحن نذكر الآن المذاهب المشهورة في الإسلام التي عليها مدار المسلمين في
أقطار الأرض ، وهي : مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، ومذهب الإمامية ، ومن كان المشار إليه من هؤلاء على رأس كلّ مئة سنة .
ثمّ ذكر أنّ الإمام الباقر هو مجدّد مذهب الإمامية على رأس المئة الأُولى ، والإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام على رأس المئة الثانية . ثمّ قال :
وأمّا من كان على رأس المئة الثالثة... أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازي من الإمامية(1) .
5 - وذكره عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمّد المعروف بابن الأثير (ت 630 ه ) في حوادث عام 328 ه ، وقال :
وفيها توفّي محمّد بن يعقوب ، (وقُتل محمّد بن علي) أبو جعفر الكليني وهو من أئمّة الإمامية وعلمائهم(2) .
6 - وقال عنه ابن حجر :
محمّد بن يعقوب بن إسحاق ، أبو جعفر الكليني ، سكن بغداد وحدّث بها عن محمّد بن أحمد (بن عبد الجبّار) وعلي بن إبراهيم بن هشام ، كان من فقهاء الشيعة والمصنّفين على مذهبهم ، توفّي سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة ببغداد(3) .
إلى غير ذلك من الكلمات الّتي لا مجال لنقلها .
إنّ التاريخ لم يسجّل رحلات الكليني في أخذ الحديث وعرضه ، إذ لا شكّ أنّه كانت له رحلات في أخذ الحديث وعرض كتابه ، فإنّ أكثر مشايخه وإن كانوا متواجدين
ص: 93
في قمّ والري ، ولكنّ قسما منهم كانوا في خارج ذينك البلدين ، حتّى أنّ بعض مشايخه كان من منطقة آذربايجان ، وبما أنّ الكليني كان ملتزما بأخذ الحديث من الراوي شفهيا ، فلابدّ من أن تكون له رحلات إلى بعض المناطق الّتي يتواجد فيها أئمّة الحديث وكتبهم .
والّذي ذكره التاريخ هو رحلته إلى بغداد عام 327 ه ، ولكنّه لم يقتصر على هذه الرحلة ، بل إنّه قصد دمشق وبعلبك ، وهذا ما يذكره الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عساكر ، حيث يقول :
محمّد بن يعقوب من شيخ الرافضة ، قدم دمشق وحدّث ببعلبك عن أبي الحسين محمّد بن علي الجعفري السمرقندي ، ومحمّد بن أحمد الخفّاف النيسابوري ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم .
روى عنه أبو سعد الكوفي شيخ الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي ، وأبو عبد اللّه أحمد بن إبراهيم (بياض في الأصل) ، وأبو القاسم علي بن محمّد بن عبدوس الكوفي ، وعبد اللّه بن محمّد .
أنبأنا أبو الحسن... (بياض في الأصل) بن جعفر ، قالا : أنبأنا جعفر بن أحمد بن حسين بن السرّاج ، أنبأنا أبو القاسم المحسن حمّزة... الورّاق بتنيس ، أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الديبلي بتنيس في المحرّم سنة خمس وتسعين وثلاثمئة ، أنبأنا أبو القاسم علي بن محمّد بن عبدوس الكوفي ، أخبرني محمّد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن إبراهيم المحاربي ، عن الحسن بن موسى ، عن موسى بن عبد اللّه ، عن جعفر بن محمّد ، قال : قال أمير المؤمنين : إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله .
أخبرنا أبو محمّد بن حمزة - بقراءتي عليه - عن أبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد . وأخبرنا أبو القاسم بن السوسي ، أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن يونس ، أنبأنا أبو زكريا . وأخبرنا أبو الحسين أحمد بن سلامة بن يحيى ، أنبانأ سهل بن بشر ، أنبأنا رشأ بن نظيف ، قالا : حدّثنا عبد الغني بن سعيد قال : فأمّا الكُليني - بضمّ الكاف والنون بعد الياء - : فمحمّد بن يعقوب الكُليني ، من الشيعة المصنّفين ، مصنّف على
ص: 94
مذاهب أهل البيت .
قرأت على أبي محمّد بن حمزة ، عن أبي نصر بن ماكولا ، قال(1) :
وأمّا الكُليني - بضمّ الكاف ، وإمالة اللاّم ، وقبل الياء نون - فهو : أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكُليني الرازي ، من فقهاء الشيعة المصنّفين في مذهبهم ، روى عنه أبو عبد اللّه أحمد بن إبراهيم الصيمري وغيره ، وكان ينزل بباب الكوفة في درب السلسلة ببغداد ، وتوفّي فيها سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة ، ودُفن بباب الكوفة في مقبرتها. قال الأمير ابن ماكولا : ورأيت أنا قبره بالقرب من صراة الطائي عليه لوح مكتوب فيه : هذا قبر محمّد بن يعقوب الرازي الكُليني الفقيه(2) .
حظيَ كتاب الكافي منذ أن ظهر إلى النور باهتمام العلماء والمحدّثين ، قراءةً واستنساخا ونشرا ، ثمّ تعليقا وشرحا ودراسةً. وإليك بعض ما يدلّ على ذلك :
قال النجاشي (ت 450 ه ) في ترجمته للكليني :
كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي ، وهو مسجد نفطويه النحوي ، أقرأ القرآن على صاحب المسجد ، وجماعة من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي ، على ابن الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب ، (حدّثكم) محمّد بن يعقوب الكليني ، ورأيت أبا الحسن العقرائي ، يرويه عنه(3) .
وهذا يعني أن الشيخ العقرائي يروي الكافي عن مؤلّفه بلا واسطة ، وهو صريح قول النجاشي : «يرويه عنه» .
ويقول في ترجمة العقرائي :
إسحاق بن الحسن بكران أبو الحسين العقرائي (وقد مرّ في ترجمة الكليني أنّه أبو الحسن) كثير السماع ضعيف في مذهبه ، رأيته في الكوفة وهو مجاور ، وكان يروي
ص: 95
كتاب الكليني عنه ، وكان في هذا الوقت علوّا ، فلم أسمع منه شيئا . وفي النسخ المطبوعة (غلوّا) ، والظاهر أنّه تصحيف (علوّا) ، والمراد به : أنّه كان طاعنا في السنّ وعلوّا في الإسناد ، حيث ينقل عن المؤلّف بلا واسطة .(1)
والشاهد على ما ذكرنا أنّ النجاشي ذكر ذلك في ترجمة أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون ، قال : ولقد لقي أبا الحسن علي بن أحمد القرشي المعروف بابن الزبير ، وكان علوّا في الوقت (أي عمّر مئة سنة ، ومات ابن الزبير سنة 348 ه )(2) .
وممّن روى كتاب الكافي عن المؤلّف المحدّث الشريف جعفر بن محمّد بن قولويه صاحب كامل الزيارات (ت 369 ه ) ، ويدلّ على ذلك ما ذكره النجاشي في سنده إلى الكافي ، يقول :
عن جماعة شيوخنا ، محمّد بن محمّد (بن النعمان المفيد) ، والحسين بن عبيد اللّه (الغضائري) ، وأحمد بن علي بن نوح (السيرافي) ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عنه(3) .
ولأبي غالب أحمد بن محمّد الزراري (ت 368 ه ) عناية خاصّة بهذا الكتاب ، يكشف عنها قوله في رسالته إلى حفيده في ذكر آل أعين :
وجميع كتاب الكافي تصنيف أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني : روايتي عنه ، بعضه قِراءةً ، بعضه إجازةً، وقد نسخت منه كتاب الصلاة والصوم في نسخة ، وكتاب الحجّ في نسخة ، وكتاب الطهر والحيض في جزءٍ ، والجميع مجلّد ، وعزمي أن أنسخ بقية الكتاب إن شاء اللّه في جزء واحد ، ورق طلحي(4) .
وفي هذا المجال يأتي قول العلاّمة الحلّي (ت 726 ه ) في إجازته للسيّد ابن مُهنّا :
وأمّا الكافي للشيخ محمّد بن يعقوب الكليني ، فرويت أحاديثه المذكورة المتّصلة
ص: 96
بالأئمّة عليهم السلام عنّي وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاووس وغيرهم ، بإسنادهم المذكور إلى الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن رجاله المذكورة في كلّ حديث عن الأئمّة عليهم السلام(1) .
أمّا التعليقات والشروح والدراسات ، فلا نرى حاجة للحديث عنها ؛ لكثرتها وانتشار عدد كبير منها .
اتُّهم الشيخ الكليني بالقول بتحريف القرآن أكثر من الآخرين ؛ وما ذلك إلاّ لأنّه أورد في كتابه روايات ربّما يستظهر منها المخالف - من دون دراسة السند والمتن - القول بالتحريف ، وقد قام غير واحد من المحقّقين بالإجابة عن هذه الروايات ببيان ضعف إسنادها وعدم دلالتها على ما يرومه الخصم ، والّذي يهمّنا هو ما ربّما يوجد في بعض النسخ عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
إنّ القرآن الّذي جاء به جبرئيل إلى محمّد صلى الله عليه و آله سبعة عشر ألف آية(2) .
وهذه رواية شاذّة لا تفيد علما ولا عملاً ، ولا يقبله العقل السليم ، مضافا إلى أنّ نسخ الكافي مختلفة ، فهذا هو المحدّث الكبير الفيض الكاشاني نقلها عن الكافي على لفظ سبعة آلاف آية(3) .
يقول المحقّق الشعراني :
إنّ لفظ (عشر) من زيادة النسّاخ أو الرواة ، والأصل هو سبعة آلاف ، فإنّ لفظة (سبعة آلاف) هي القريبة من الواقع الموجود بأيدينا ، وظاهر الحديث أنّه ليس بصدد إحصاء عدد الآيات ، بل الغاية من ذلك إطلاق العدد التامّ المتناسب مع الواقع بعد
ص: 97
حذف الكسور أو تتميمها ، كما هي العادة والمتعارف في الاستعمال(1) .
والعجب أنّ خصوم الكليني بين من ينقله عنه بلفظ سبعة عشر ألف آية ، كالآلوسي(2) ، وبين من ينقله بلفظ سبعة آلاف آية ، كموسى جار اللّه (3) .
غير أنّ أحد خصومه كأبي الحسن الندوي ، لم يرتض كلا العددين ، فنقله في رسالته(4) بصورة : سبعين ألف آية .
والّذي أقترحه على اللجنة المشرفة على تصحيح الكافي دراسة الموضوع ،
وملاحظة النسخ قديمها وحديثها حتّى يتجلّى الحقّ بأظهر صوره .
1 - التعليق على المواضيع الّتي روي فيها الحديث معلّقا أو الإسناد محوّلاً ، أو نقل بلفظ «بهذا الإسناد» ، أو «بالإسناد» ، فيجب توضيح هذه الموارد في كلّ صفحة ورد فيها دون أن يقتصر على موردٍ واحد ، وعطف عليه سائر الموارد .
2 - تفسير المفردات المشكلة في النثر والنظم الواردين في الكتاب .
3 - التعليق على الأحاديث الشاذّة الّتي لا تتّفق مع ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة ، أو ما اتّفقت عليه الإمامية .
4 - نشر الكتب الّتي نقل عنها الكليني بواسطة أو بلا واسطة ، كبصائر الدرجات والمحاسن للبرقي ، والنوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى ، إلى غير ذلك ممّا يمكن أن نصل إليه في المكتبات .
5 - إنّ للشيخ الكليني كتابا - كما ذكرنا - باسم رسائل الأئمّة عليهم السلام وكان هذا الكتاب موجودا عند ولد الفيض ، حيث ينقل عنه في كتابه : مكاتيب الأئمّة عليهم السلام» بلا واسطة ،
ص: 98
فيجدر بأصحاب هذا الشأن البحث عنه في مكتباتنا ، فربّما يكون موجودا فيها .
6 - البحث عن «روضة الكافي» والتوفّر على دراسته ؛ للتأكّد هل هو من تأليفه أو لا؟ وعلى الأوّل ، فهل هو جزء من الكافي ، أو كتاب مستقلّ؟
7 - الفحص عن قبره في بغداد والاهتمام به ، فقد اتّفق المترجمون على أنّه دُفن في باب الكوفة ببغداد ، وقيل : إنّ قبره في درب السلسلة ببغداد بالقرب من صراة الطائي(1) .
8 - التحقيق والفحص عن قبور نوّاب الإمام المهدي عليه السلام الأربعة رحمهم الله .
هذا ما سنح به الوقت لأن نقدّمه إلى الأُخوة الكرام المشاركين في المؤتمر العالمي لثقة الإسلام الكليني رحمه الله ، عسى أن نشاركهم في هذا الثواب الجزيل ، وأن يكون خدمة متواضعة لروح هذا المحدّث الكبير الّذي لم يزل يشعّ نور كتابه على العالم الإسلامي أجمع .
وفي الختام ، نتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى الأُخوة المحقّقين والمشرفين في مؤسّسة «دار الحديث» العامرة . والحمد للّه ربّ العالمين .
ص: 99
ص: 100
منهجية الكليني في «الكافي»
علي محمود البعاج
«وَ مَآ ءَاتَائَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَلاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ»(1)
حمدا لك اللّهمّ وصلاةً وتسليما على عباده الذين اصطفى: محمّد وآله الهداة المهديّين «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» ، وعلى صحبه الأبرار المنتجبين «مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُو أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ» ، والشهداء والصدّيقين والعلماء الربّانيّين «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَؤُاْ».
وبعد ، فقد قيّضت المشيئة الإلهيّة والإمدادات الغيبية للحديث الشريف حفظة ، تداولوه بالدرس والتدريس ، وتعاهدوه بالإبانة والتوضيح ، ولم تثنهم عن ذلك طوارق الحدثان ، وذهبوا في ذلك مذاهب شتّى ، ولا ضير ، فإنّ الوصول إلى اللّه «بعدد أنفاس الخلائق»، والحديث المطهّر الامتداد الطبيعي للذكر الحكيم «وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى» ، وهو أعرف من أن يُعرّف وأقدس من أن يُحرّف .
وأمّا الكليني فهو وريث المتكلّمين، من أئمّة المحدّثين ، والرعيل الأوّل في الفقهاء الروحانيين من عمد الدين وأركان المذهب ، هو الذي ارتحل من كلين - الري ، وما أدريك ما الري؟ ولودة المحدّثين ، وليطلب الرواية ويدعو الناس إلى الاعتصام
ص: 101
بذمام السنّة الشريفة ، وغاص في عالم من المعرفة فسيح لينظم «الكافي» كافيا شافيا ، أُنموذجا موثقا يرقى بين عنوانات المحدّثين إلى جنب صحيح البخاري ومسند أحمد وموطّأ مالك، وخلاصة «الأُصول الأربعمئة» عند الإمامية وكفاه.
وأما أنا - وأعوذ باللّه من «أنا» - «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُم بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى» ، فالقصور يمشي على قدمين ليدلف إلى أروقة المؤمر العتيد ، والتقصير مجسّداً في اثنتين :
فيّ وفي هذه الوريقات ، وما عساي إلاّ أن تنال رضا مصدّر الكافي الأعظم «محمّد» الأُسوة الحسنة والرحمة المهداة ، وأن تنعم بقبول الأساتذة المشرفين لترى النور.
واللّه أدعو ببركة الكافي أن يكفينا المهمّ كلّه.
واللّه أسأل ببركة «الكليني» أن لا يكلنا إلى أنفسنا - كلّنا - طرفة عين أبدا، فإنّه الكافي لا كافي سواه ، ومنه تعالى نستمدّ الاعتصام.
من النهج ، وهو الطريق ، وطريق نهج ؛ أي بيّن وواضح(1)، والمنهاج : الطريق الواضح ، ونهج الطريق : سلكه(2) ، وفي القرآن الكريم: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا».(3)
والمنهج هو ترجمة المفردة الفرنسية (Methode) ، وتقابلها في الإنكليزية (Method) ؛ بمعنى الطريقة.
أجمع التعاريف وأمنعها هو :
ص: 102
الطريق المؤّي إلى الكشف عن الحقيقة والعلوم بواسطة طائفة من القواعد العامّة التي تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته حتّى يصل إلى النتيجة المعلومة.(1)
والمنهج منهجان: المنهج التلقائي ، والمنهج التأمّلي .
والثاني ينقسم إلى فرعين رئيسيين:
1 - المنهج العامّ : وتُدعى المناهج المنطقية.
2 - المنهج الخاصّ : ويُطلق عليها المناهج الفنّية.(2)
القسمعدد الأجزاء1 - الأُصول22 - الفروع53
- الروضة1
وعليه ، فإنّ مجموع الأجزاء يصبح ثمانية بحسب الطبعات الأخيرة.
الريادة في تبويب الأحاديث من ميزات الكافي التي تُذكر ، وعموما فإنّه قسّم الأُصول منه إلى كتب ، والكتب إلى أبواب ، ولم يكن هذا التبويب متّسقا مبرمجا ، فقد تباينت عدد الأحاديث من بابٍ لآخر ، كما أنّ تصنيف الكتب إلى أبواب غير منسق، وهو ما يتّضح لدينا في المخطّط أدناه:
ص: 103
الجزء الكتاب عدد الأبواب عدد الأحاديث الأُصول الأوّل
1 - العقل والجهل 2 - فضل العلم 3 - التوحيد 4 - الحجّة بلا 23 36
132341762121015الثاني 1 - الإيمان والكفر 2 - الدعاء 3 - فضل القرآن 4 - العشرة
209 60 14 311609409124204الإجمالي جزءان 8 كتب 505 أبواب3783 حديثا
نَهجَ شيخنا الكليني في تبويبه للأحاديث في الفروع طريقة المصنّفات والجوامع عند المذاهب الأُخرى ، فقد عمد إلى ترتيبها وفق أبواب الفقه المتعارف عليها. وهذا لا يُقصد منه إدراج الكليني والصدوق مثلاً في قائمة المحدّثين فقط ، بل انضمّوا إلى جانب روايتهم للحديث إلى الفقهاء ذوي الفتوى ، وكانت فتاواهم - الفقهاء - بعد الكليني نصوص أحاديث مع إسقاط الإسناد وبعض الألفاظ في بعض الحالات.(1)
إنّ أعمال المكلّفين بحسب الإمامية إمّا أن يكون فيها نيّة التقرّب إلى اللّه ، أو لا ، والأوّل هي العبادة ، وعلى الثاني إمّا أن يكون منه من طرفين أو من طرفٍ واحد، وعلى الأوّل: عقود ، وعلى الثاني: إيقاعات ، وإلاّ فهو سياسة.(2)
ص: 104
وقد حصدت «الفروع» الأجزاء: «3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7» من كتاب الكافي ، وعليه يمكن أن نرصد بعضا من التداخل بين العقود والإيقاعات.
ت الكتابت الكتاب1
الطهارة14
الصيد2
الحيض15
الذبائح3
الجنائز16
الأطعمة4
الصلاة17
الأشربة5
الزكاة18
الزي والتجمّل والمروءة6 الصيام19
الدواجن
الحجّ20 الوصايا
8
الجهاد21
المواريث9
المعيشة22
الحدود10
النكاح23
الديّات11
العقيقة24
الشهادات12
الطلاق25
القضاء والأحكام13 العتق والتدبير والكتابة26 الأيمان والنذور والكفّارات1776 باباً10911 حديثاً
شغلت الروضة الجزء الثامن من الكافي، وهذه الروضة على مسمّاها تجد فيها الجمّ الغفير من الأخبار والمرويات ممّا لا يمكن إدراجه تحت عنوان ، أو يمكن ذلك .
فمن القراءات إلى التفسير ، ومن قصص الأنبياء إلى خطب الأئمّة ورسائلهم
ص: 105
ومواعظهم ، إلى أشتاتٍ من الأخلاق والآداب والتاريخ ، وليس بالمستغرب أن تجد فيها من الطبّ شيئا، كتداوي الأمراض والحجامة، وحتّى الفلك والجغرافيا.
إلى هذا ، فإنّ المنهجية في التبويب تختلف عن توأميها (الأُصول والفروع) ، حيث لم تقسّم هنا إلى كتبٍ وأبواب ، ويرى البحث أنّ تصنيف أحاديث الروضة وتقسيماتها ضمن عنوانات متميّزة لهو من ضرورات المنهج العلمي للحديث.
دأب الفقهاء الإماميون القدامى منهم وليس المحدّثين(1) في مفتتح مدوّناتهم الفقهية على كتابة رسالة عقائدية في إثبات الصانع ، وهم قد سلكوا منهجية الكافي في ذلك، حيث مباحث التوحيد وأُصول الدين في الأُصول من الكافي ، وهي تحمل السمة الكلامية ، أُطلق عليها «الفقه الأكبر» من لدن بعض الفقهاء.
وتلك - فيما يرى البحث - منهجية منطقية ، إذ إنّ الدين الإسلامي (العقائد، الفقه، الأخلاق) منظومة ترابطية وحلقات متكاملة ، فمهما صحّت المقدّمات صحّت النتائج.
وللكليني مديات أرحب في هذا المجال العقائدي ، فهو يكمل نظريات ضخمة وآراء كلامية بحكم البيئة المعاشة ، إنْ في الري أو في بغداد ، وبحكم العصر وأدواته ،والتي شهدت ازدهار الحركة العقلية في الفكر الإسلامي ، حيث تبلورت فيها مناهج كلامية امتدّت تأثيراتها حتّى إلى الصعيد الفقهي والفتاوى الشرعية ، فأصبح لكلّ
ص: 106
منهج ومدرسة - إلى جنب التمذهب الفقهي - نموذج كلامي عقيدي: أشعري، معتزلي، إمامي، مرجئي أو خارجي .
ونعني بها علوما غير علوم الحديث والتي عالجها الكليني في مواطن متفرّقة من كتابه، أُصولاً وفروعا وروضةً .
له إلمام واسع وباع طويل في معرفة الحوادث التاريخية واستقراء النصوص التاريخية بما يعينه على إيضاح مروياته ، وليس ذلك بكثير على الكليني ، إذ علمنا من خلال آثاره أنّ له كتابا في الرجال وإن يكُ مفقودا، وفي الروضة والأُصول تجد كمّا هائلاً من اللفتات التاريخية، بل حتّى في الفروع ، إذ يذكر قصّة حفر بئر زمزم في الفروع - الحجّ - وكتاب الحجّة من أُصوله غني بهكذا موضوعات ، إذ تطرّق إلى ولادات الأئمّة ووفياتهم . وفي باب مولد الإمام الرضا قال:
ولد أبو الحسن الرضا عليه السلام سنة ثمان وأربعين ومئة ، وقُبض عليه السلام في صفر من سنة ثلاث ومئتين وهو ابن خمس وخمسين سنة ، وقد اختُلف في تاريخه ، إلاّ إنّ هذا التاريخ أقصد إن شاء اللّه .(1)
مع الالماع إلى مناقبهم.
تحدّثنا في مبحث غير هذا أنّ الدين منظومة ترابطية بين العقائد والفقه والأخلاق ، وعليه ، فإنّ الأخلاق ثالثة ثلاث يكتمل بها الاعتبار الإيماني ، ولم يغفل الكليني عن هذه التفاصيل ، فتطرّق لها ضمن الأُصول من كافيه ، وكانت أبواباً عديدة تحمل
ص: 107
البصمات العرفانية من كتاب الإيمان والكفر:
في أُصول الكفر وأركانه ، باب اختتال الدنيا بالدين ، باب الطمع ، باب سوء الخلق ، باب السعة . ونورد هنا نموذجا من باب الفخر والكبر تيمّنا بهذه الأحاديث الشريفة.
علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : آفة الحسب الافتخار والعُجب.(1)
ولعلّه من تتمّات هذه الأحاديث النورانية: إنّ السيّد الخميني استقى مصادر أحاديثه في الأربعون حديثا وبعضا من أحاديثه في أسرار الصلاة والآداب المعنوية للصلاة من أُصول الكافي .(2)
حينما صدّر الكليني كتابه بالمقدّمات الاعتقادية التي تتمحور حول أُصول الدين والجبر والاختيار والقدم والحدوث والبعث والنشور وما إلى ذلك، فإنّه عالجها بحكمة المتكلّمين ومنهج العقائديين، ألا ترى أنّ لديه إرثا ضخماً من مدرسة الري ، ثمّ صقلتها مدرسة بغداد ، وكان شديد الغيرة على العقائد الإسلامية ، يتجلّى ذلك في كتابه الردّ على القرامطة ، ولعلّك بمنتهى اليسر تعثر على هذه المباحث من خلال كتاب التوحيد وكتاب الحجّة من أُصول الكافي .
إنّ انتقائيته لهذه الروايات (نبوية أم إمامية) ، ينمّ عن مقدرة كبيرة في هذا المتّجه .
عن إسحاق بن عبد العزيز بن أبي السَّفاتِج ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سمعته يقول: إنّ اللّه اتّخذ إبراهيم عليه السلام عبدا قبل أن يتّخذه نبيّا ، واتّخذه نبيّا قبل أن يتّخذه رسولاً ، واتّخذه رسولاً قبل أن يتّخذه خليلاً ، واتّخذه خليلاً قبل أن يتّخذه إماما ، فمن عظمها في عين إبراهيم ، قال: يا ربّ ومن ذرّيتي ، قال: لا ينال عهدي
ص: 108
الظالمين.(1)
بغية التحقّق من عدم التسامح في تحمّل الحديث ونقله ، وتلافيا لمشكلة الوضع والوضّاعين، وأنّ حلقات هذه السلسلة تنتهي غالبا بأحد الصادقين عليهماالسلام أو بأحد المعصومين ، وبطبيعة الحال فإنّ حديث الإمام هو حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذلك من المسلّمات عند الإمامية لحديث ثامن الأئمّة الرضا عليه السلام المعروف بحديث السلسلة
الذهبية، وهو ما لمسه البحث في كلّ أبواب الكافي :
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داوود بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: من تعصّب أو تُعصِّب له ، فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه.(2)
كثيرة هي المصنّفات الرجالية ، وقد شهدنا من صنّف على ترتيب السنين ومنهم على حسب البلدان، فيذكر فضائل البلد المؤّخ لعلمائه ، ومن سكنه من الصحابة أو مرّوا به ، ثمّ علماء ذلك البلد ومن دخله من أهل العلم ، ومنهم من رتّبها على حروف المعجم، ومن تلكم الكتب:
1 - كتب الصحابة ، منها: أُسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري .
2 - كتب الطبقات ، وهي التي تشتمل على ذكر الشيوخ وأحوالهم ومروياتهم،
ص: 109
طبقة بعد طبقة وعصرا بعد عصر إلى زمن المؤّف، وإنّما نُظّمت على الطبقات لتسهيل التمييز بين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ، فيُميّز الحديث المرسل أو المنقطع، ومن أشهرها: الطبقات لابن سعد.
3 - كتب الجرح والتعديل.
4 - كتب الأسماء والكُنى والألقاب.
5 - كتب الأنساب.(1)
إنّ الفروع من الكافي على وجه الخصوص تثبت بجلاء أنّ الكليني على معرفة تفصيلية برجال سنده . إنّ التوصيف جاء هنا بعدّة صور يسرد البحث بعضا منها:
1 - ذكر المهنة: «عن أبي محمّد مؤن علي بن يقطين» ج 6 ، الزي والتجمّل والمروءة.
2 - ذكر اللقب: النوفلي، السكوني، أو «عن أبي جعفر البغدادي» ج 4، الزكاة.
3 - ذكر العلامات الفارقة: «عن حارث الأعور» ج 6، الأطعمة.
4 - ذكر البلد: «عن رجلٍ من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن» ج 6، الزي والتجمّل والمروءة.
5 - ذكر الكُنية: «عن الهيثم أبي روح» ج 5، الجهاد.
6 - ذكر الحرفة: «عن زيد الشحّام» أو «عن يزيد الصائغ» ج 7، المواريث. و ج 3، الجنائز.
7 - ذكر الأقارب: «عن الحسين بن حازم الكليني ابن أُخت هشام بن سالم» ج 7، الوصايا.
8 - ذكر النسبة: «عن شيخ من أصحابنا الكوفيّين» ج 5، المعيشة.
ص: 110
قد يلجأ الكليني في سنده أن يروي عن أكثر من واحدٍ في طبقة من طبقات رواته أيّا كانت.
إنّ المعالجة العلمية الحديثية لهذا الأمر تكمن في تلافي «الجرح» وتأكيد «التعديل» في السلسلة السندية، فقد تكون حلقات في السلسلة مجهولة ، مثل: «عمّن حدّثه» أو «عمّن رواه» ، أو يكون هناك رواة ضعاف أو مضعّفون أو يكون مفاد الرواية هامّا ، أو غير ذلك ، فيتجاوز الكليني بكفايته المعهودة في علم الرجال بالإكثار من رجال طبقاته . وعلى أيّة حال ، فإنّ التعدّدية في الرواة تأتي على ضروبٍ عدّة :
عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب وعلي بن
الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال: ... .(1)
عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح وأبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد... .(2)
وبهذه الصيغ في التعامل مع الإسناد يضفي الكليني عليها قوّة ودعما ، ويظهر تحرّجه في الأداء.
1 - الطريق الواحد للرواية: وهذا ما لاحظه البحث في الأعمّ الأغلب من أحاديث الكافي .
ص: 111
2 - الرواية بطريقين: ومثال ذلك أسناده:
علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سلام بن عبد اللّه
ومحمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد وأبو علي الأشعري ، عن محمّد بن حسّان ، جميعاً عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن سلام بن عبد اللّه الهاشمي ... .(1)
3 - الرواية بثلاث طرق: ومثال ذلك أسناده:
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن
عمرو بن عثمان ، عن عثمان محمّد بن عبد اللّه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وعدّة من أصحابنا أيضاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضّل بن عمر ، قال: قلت لأبي عبد اللّه... .(2)
نهج في ذلك الكليني البغدادي صيغاً شتّى ، منها:
1 - ذكر عدّته :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلا ، قال: قلت لأبي عبد اللّه ... .(3)
أو بذكر أحيانا : «بعض أصحابنا» .
2 - الإحالة على أسانيد روايات أُخَر بصيغة «وبهذا الإسناد» :
وبهذا الإسناد قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ... .(4)
3 - العلوّ في السند، والعلوّ : «هو قلّة عدد الرواة مع اتّصال السند»،(5) فيتوخّى الشيخ
ص: 112
الاختصار قدر ما أمكنه من الصحابة والشيوخ وصولاً إلى الإمام عليه السلام .
عنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللّه... .(1)
من منهجية الكليني في معالجات السند الروائي هو استقطابهِ لطيفٍ واسع من المصادر، ولعلّك واجد مصادر استثنائية كما يتّضح في ثنايا بحثنا هذا.
أ . المعصومون عليهم السلام .
ب . صحابة الرسول صلى الله عليه و آله ، ومنهم عمر بن الخطّاب،(2) وجابر بن عبد اللّه الأنصاري .
ج . التابعون وتابعوهم.
د . من المذاهب الإسلامية الأُخرى ، كروايته عن سفيان بن عيينة،(3) وابن البختري والأوزاعي، والزهري،(4) إذ يعدّ من التابعين ، ولكن أدرجناه هنا لأنّه على غير مذهب الإمامية .
أ . النساء ، وتشمل:
أوّلاً : أُمّهات المؤنين ونساء صدر الرسالة ، مثلما روي عن عائشة وأُمّ هانئ وفاطمة بنت أسد .(5)
ص: 113
ثانياً : نساء عامّة المسلمين ، مثل جويرة أُمّ عثمان ، وعمّة الحسن بن مسلم.(1)
ب . من المخالفين:
أوّلاً : عن الفطحية ، مثل الحسن بن علي بن فضال ، وعلي بن أسباط.(2)
ثانياً : عن الواقفية ، مثل عثمان بن عيسى الرواسي، شيخ الواقفة.(3)
ج . مصادر غير معرّفة: بصيغة «عمّن رواه» و «عمّن حدّثه» ، وتكمن معالجته لهذه الأحاديث المبهمة بروايتها عن طريقٍ آخر .
المتن سنّة ، والسنّة لغةً : الطريقة ، حسنة كانت أم سيّئة، ومنه قوله صلى الله عليه و آله :
من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ سنّة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
والسنّة اصطلاحا : أقوال النبيّ صلى الله عليه و آله - وعند الإمامية المعصوم(4) - وأفعاله وتقريراته،وصفاته الخَلقية والخُلقية، وسيره ومغازيه ، سواء كانت قبل البعثة أم بعدها.(5) فأقواله مثل قوله صلى الله عليه و آله : «إنّما الأعمال بالنيات» ، وأفعاله مثل إدائه الصلاة ومناسك الحجّ لقوله صلى الله عليه و آله : «خذوا عنّي مناسككم»، وتقريراته هي ما أقرّ الرسول أفعالاً قام بها بعض صحابته بسكوتٍ منه مع الرضا ، أو بإظهار استحسان لتلك الأفعال في حضوره أو غيبته وعَلِمَ به.
ص: 114
ويلاحظ أنّ كلمة السنّة عند الإمامية تشمل أقوال المعصومين من أئمّتهم وهم الاثنا عشر،(1) فأقوالهم سنّة متبعة لا محالة.(2)
أمّا حجّية السنّة المطهّرة فإنّها من الضروريات لدى المسلمين ، واستقلالها بتشريع الحكام ضرورة دينية ، ولا يخالف في ذلك إلاّ من لا حظّ له في دين الإسلام.(3)
التقديم لأحاديثه ومروياته بغية الإحاطة التامّة بأجواء النصّ ومكنونه ، فإنّه في حالات معيّنة افترضت منهجيته ذلك بأن يقدم من عندياته ما يدعم الفكرة ويوصل المفهوم:
إنّ اللّه تبارك وتعالى جعل الفرائض على أربعة أصناف ، وجعل مخارجها من ستّة أسهم.(4)
فيما سبق بيّنا أنّه لغرض التوسعة في المعنى فإنّ الكليني يقدّم لبعض أحاديثه ، أمّا هنا فالحال مختلف منهجا، فهو يردف أحاديثه بما يعين على فهم النصّ، إنّه يتعقّب بعض المفردات القرآنية التي هي ذات مدلول وأثر من خلال أحكامها التكليفية ، فيوضح: الخمس، الغنائم، الفيء ، والكلالة.
إنّ تعرّضه لهكذا مفردات كان في الفروع أكثر ممّا هي في الأُصول ؛ لطبيعة أبوابها، كما أنّ التداخل حاصل بين هذه المواضيع ، فالفقه نشأ في أحضان الحديث - كما يعبرون - وكان الفقهاء أخباريّين، أي أنّهم اعتمدوا الحديث أكثر%
ص: 115
من اعتمادهم في استنباط الأحكام على مصادر التشريع الأُخرى، إضافة إلى ملحوظتين أجد مهمّا ذكرهما ، ألا وهما:
1 - إنّ هذه المرويات - نبويّة كانت أم إمامية - تعدّ من (فقه السنّة).
2 - إيراد هذه الأحاديث ، وهي تتضمّن شروحات لنصوص قرآنية نعتبره تفسير ال-(آيات الأحكام)، أو ملمّحا مهمّا من ملامحه على أدنى مستوى ذلك التفسير الذي اعتمد المأثور من السنّة المطهّرة ، الذي اصطلح عليه «التفسير الروائي» أو «التفسير الأثري» أو «التفسير النقلي» ، وهي تفاسير محورية ضمن منظومة التفاسير الواسعة الطيف ، وقد شهدنا في الإمامية الكثير منها، فعلى سبيل الاستشهاد :
تفسير فرات الكوفي.
تفسير العيّاشي.
تفسير النعماني.
تفسير البرهان.
تفسير نور الثقلين.
ومن المذاهب الأُخرى:
تفسير الدرّ المنثور.
تفسير ابن كثير.
تفسير جامع البيان.(1)
عود على بدء حول المصطلحات القرآنية، فمن النمذجة لذلك يوضّح الكليني معنى «الكلالة» بقوله:
وهم الأُخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان ، وإن كان للميت ولد ووالدان أو واحد منهم لم تكن الأُخوة والأخوات كلالة ؛ لقوله عزّ وجلّ ... .(2)
ص: 116
قلنا فيما سبق إنّ هذه المرويات تشكّل أساسات تفسيرية لمنهج التفسير الروائي، وفي الوقت ذاته (فقه سنّة).
إلى ذلك ركّز الكليني على إيضاح المطالب متى رأى الأمر مستوجبا ، مثل: «نكاح الشغار»، «الإيلاء»، و«الظهار» إذ يعقّب على رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام بقوله - أي الكليني - :
يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنتِ عليَّ حرام مثل ظهر أُمّي أو أُختي ، وهو يريد بذلك الظهار.(1)
الكليني البغدادي أجاد العربية إجادة مكّنته من فهم النصّ ، ولا ريب أنّ الفقهاء أحذق في استفادة المعنى من اللغويين ، كما أنّ المحدّث الكليني أخذ بأطراف علوم الحديث الشريف وأولوياته وخبر لغة الحديث. والمتتبّع جدّ عليم بما انطوت عليه ثقافة الكليني من سعةٍ وعمومية وارتكاز ، نرى ذلك في تقسيماته للجراحات :
«أوّلهما تسمّى الحارصة ، وهي التي تخدش ولا تجري الدم، ثمّ الدامية ...» ثمّ ذكر بقيّة الجراحات.(2)
إجادة الكليني للعربية وإحاطته الواسعة بها كما سلف اتّخذت صورا شتّى ، من ذلك : تذوّقه للنصوص الشعرية واستيعابه لها ، وقد رصد البحث ضمن مؤّفاته أنّه دوّن كتابا عمّا قيل في الأئمّة من الشعر، وما يهمّنا هنا هو تضلّعه بالعربية ، ومنها شواهده الأدبية ، فهناك أبيات لأبي طالب رضى الله عنه في أكثر من موقع ، وقد يورد بعض الشواهد
ص: 117
لتعزيز معاني الآيات أو إيضاح المبهم منها، إذ ذكر في خلال معنى الصمد:(1)
علوته بحسامٍ ثمّ قلت له *** خذها حُذيف فأنت السيّد الصمد(2)
إنّ السنّة المطهّرة مرّت بأربع مراحل كما يقسّمها أصحاب علوم الحديث ، وهي ذات الأدوار التاريخية لتطوّر التفسير الروائي:
أوّلاً : مرحلة النبي صلى الله عليه و آله .
ثانياً : مرحلة الأئمّة عليهم السلام .
ثالثاً : مرحلة الصحابة والتابعين وتابعيهم.
رابعاً : مرحلة التدوين الروائي.(3)
يرى الشيعة أنّ الصحيفة الاُولى المدوّنة هي صحيفة الإمام علي عليه السلام ، كان يقوم بكتابة كلّ ما يمليه عليه الرسول صلى الله عليه و آله بخطّه ، فسمّاها بعضهم ب-«الجامعة» أو «الصحيفة» ، أو «كتاب علي» ، وذهب بعضهم إلى أنّها تحتوي على كلّ شيء من الأحكام حتّى أرش الخدش ، لكن لم يستيقن البعض من شموليتها،(4) وقد ورد أنّ الإمام الثامن الرضا عليه السلام قد كتب على ظهر العهد الذي عهده إليه المأمون العبّاسي بخصوص ولاية العهد ما يشير إلى وجود تلك الصحيفة عنده.(5)
ومن المفارقات اللافتة للتأمّل أنّ البخاري في صحيحه اعتمد على روايات تلك
ص: 118
الصحيفة في كتاب: «الجهاد»، «الديات»، «الحجّ» «الجزية»، وبعض الأبواب الأُخرى.(1) إضافة إلى الصحاح والمسانيد الأُخرى ، كصحيح مسلم ومسند أحمد والقرطبي والبغدادي .(2)
وكذلك كانت مدوّنة عبد اللّه بن عبّاس حبر الأُمّة الذي كان مغرما بالكتابة ، ومن تلاميذه التابعي الجليل الشهيد سعيد بن جبير رضى الله عنه .
وأوّل من دوّن الأحاديث بعد الإمام علي هو أبو رافع القبطي مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، الذي شهد مع النبيّ مشاهده ثمّ لازم بعده عليّا وصار صاحب بيت ماله في الكوفة ، وقد رتّب أبو رافع الحديث على الأبواب ، فاشتُهر بكتابه في السنن والأحكام والقضايا.
ثمّ كانت أبرز المدوّنات الكتاب المنسوب إلى الصحابي الجليل سلمان المحمّدي الفارسي (ت 37 ه )، والمسمّى بحديث الجاثليق،(3) وكتاب ميثم التمّار ، وهو من خواصّ الإمام عليّ وتابعيه، وكتاب سليم بن قيس الهلالي، قيل إنّ الإمام علي بن الحسين قال بعد أن قرأ الكتاب بتمامه: «هذه أحاديثنا صحيحة» .
ثمّ كتب علي بن أبي رافع القبطي وهو من التابعين جملة من الأحاديث المتّصلة بالوضوء والصلاة وغيرهما من أبواب الفقه ، وجمعها على شكل كتاب.(4)
صنّفت الإمامية من عهد أمير المؤنين عليه السلام إلى عصر أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام أربعمئة كتاب تُسمّى بالأُصول.(5)
ص: 119
وسُمّيت بعد ذلك ب-«الأُصول الأربعمئة»، وذلك خلافا لبقية المدوّنات ؛ لأنّ جميع الأحاديث الواردة فيها قد سُمعت مباشرةً وشفاها من الإمام ، أو كان لها طريق واحد فقط بين الراوي والإمام.(1)
وحيث إنّ هذه الأُصول الأربعمئة لم تخضع للمنهجة والبرمجة ولم يكن لها ترتيب أو تنسيق خاصّ ؛ لأنّ جلّها من إملاءات المجالس وجوابات المسائل النازلة المختلفة ، فقد عمد وبعد تنامي الحركة العلمية ونشاطها عدد من أقطاب الإمامية إلى تأليف بعض المجاميع الحديثية القائمة على أساس منهجي مبوّب على أن تكون مادّتها الرئيسية الأُصول الأربعمئة ،(2) فكانت الكتب الأربعة وعلى رأسها وفي مقدّمتها وريادتها الكافي ، وهنّ : الكافي ، من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي (ت 381 ه ) ، كتابا التهذيب والاستبصار ، وكلاهما لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي(ت460ه ).(3)
وأصبحت هذه الأربعة في قبالة الصحاح الستّة عند أهل السنّة.
الكليني كان أثرا من آثار عصره ، ونتاجاً من نتاجات بيئته، فبيئته (كلين - الري) مدرسة حديثية النزعة ، وعصره - القرن الهجري الرابع - عصر تمايز العلوم واستقلاليتها ، وما بين ذين كان الكافي مدوّنة موسوعية حديثية جمعت بين مزايا مدرسة الري ومدرسة بغداد في الحديث، وألقى القرن الرابع الهجري بظلاله على الكليني فأضحى (التدوين).
قضى حياته مهاجرا بين الأمصار ومنتقلاً بين الأقطار ؛ بحثا عن حديثٍ أو رواية ،
ص: 120
واستقرّ به المقام في بغداد ، وهي يومذاك مركز العالم الإسلامي وحاضرته العلمية والسياسية ، نشأت بها المدارس ودور العلم ، وازدهرت مجالس النظر والجدل ، وكانت مثابة العلماء وملتقى المتكلّمين ومنتدى الأُدباء . والعصر الذهبي للعلوم كان قرن الكليني «فقد رغب الأحداث في التأدّب والشيوخ في التأديب ، وانبعثت القرائح ونفقت أسواق الفضل وكانت كاسدة».(1)
لقد نشطت الحركة العلمية واتّسعت المعارف والعلوم العقلية والنقلية ، فعلى النقيض من الحياة السياسية المضطربة الهوجاء ، كانت الحياة الفكرية والعهد العلمي في أخصب فترة وأزهى مرحلة ، حينها انبرى الكليني في الشروع بتدوين كافيه ، وقد كان أوّل فقيه إمامي محدّث يصل إلينا كتابه في الحديث - كموسوعة - بعد عصر النصّ ، أي الغيبة الصغرى عند الإمامية ؛ لأنّ الفقهاء كانوا يستمدّون نصوصهم التشريعية من الطبقة التالية لعصر الأئمّة.
إنّ الكافي من بين آثاره - وكلّها مفقودة - الأشهر ذيوعا والأكثر صيتا والأوثق نقلاً، حتّى لقد عُرف به ، فقيل : كتاب الكليني «صنّف كتابه الكبير المعروف بالكليني ، يُسمّى الكافي».(2)
لولا تصدّي هؤاء المحدّثين والشيوخ من أقطاب مدرسة آل البيت ومنهم شيخنا الكليني إلى جمع وتدوين الأحاديث الشريفة ، لاندرست ثروتنا التشريعية أو معظمها ، ولآل أمرها إلى الضياع.
وبلغ الأمر من عنايتهم بهذه الموسوعة الحديثية - أي الفقهاء والعلماء والمحدّثون - أن تعاهدوها بالاستنساخ والطبع والترجمة والشروحات وتعليقات الحواشي عليها ، ومن اهتمامهم الفائق بها أن درسوا بعضا من أُمورها وأبوابها وكذلك اختصروا بعض أحاديثها، فما أعهد المصنّفات الحديثية في مختلف الأدوار بعده إلاّ
ص: 121
واعتمدته ، نورد بعضا منها أُنموذجا :
الصدوق (ت 381 ه ) في كتاب من لا يحضره الفقيه .
الطوسي (ت 460 ه ) في التهذيب والاستبصار .
الفيض الكاشاني (ت 1091 ه ) في الوافي .
الحرّ العاملي (ت 1042 ه ) في وسائل الشيعة .
المجلسي (ت 1111 ه ) في بحار الأنوار .
عبد اللّه الكاظمي في جامع الأحكام .
وما يصدق على كتب الحديث يصدق على الفقه والفقهاء ، فقد أورد الطوسي والحرّ العاملي نفس نصّ الكافي في الحديث الآتي :
روى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام ، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، وإنّما يقسّمها على قدر من يحضر منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤّت.(1)
وكذا الشيخ المفيد في معرض تحريمه نقل الأموال الزكوية من بلدانٍ أُخر مع وجود المستحقّين لها في البلد المنقول عنه.(2)
للكافي منهجيتان: منهجية عامّة فيما يتعلّق بتبويب الكتاب وبعض ملامحه العامّة ، ومنهجية خاصّة (فنّية) في التعامل مع الحديث سندا ومتنا .
كان رائد التبويب الحديثي ،فقد كانت الفروع من الكافي بحسب أبواب الفقه، وقد حذا حذوه الفقهاء من بعده، ومن أبرزهم الشيخ المفيد في مقنعته.
مباحث (الفقه الأكبر) العقائدية كانت في بدايات الموسوعة.
ص: 122
ثقافة الكليني موسوعية،وقد عالج موضوعات فيها من التاريخ وعلم الأخلاق وعلم الكلام والعربية وآدابها.
للكليني معالجات محدّدة سندا ومتنا ، غايته فيها التحرّج بتحمّل الحديث والأمانة في الأداء والتثبّت في النقل.
تعدّدية الرواة في طبقة واحدة من أسناده ، وتعدّدية الطرق ذاتها ، أهمّ سمتين لتلافي (الجرح) وتأكيد (التعديل) في مروياته.
الانفتاحية وكذا النأي عن التعصّب المقيت ، كانت الصفة الغالبة في نتاجه الكافي ، منها روايته عن رموز المذاهب الإسلامية الأُخرى ، وأروع من ذلك روايته عن المخالفين ، مثل: الأفطحية والواقفة.
للعنصر النسائي حضور متميّز في هذه الموسوعة ، فقد روى عن عائشة ونساء صدر الرسالة ونساء عامّة المسلمين.
سنّة المعصوم عليه السلام كسنّة النبي صلى الله عليه و آله ، وسند الحديث المنتهي إلى الإمام يعدّ سندا منتهيا إلى النبيّ صلى الله عليه و آله .
تفاعل الكليني مع المتن بروحية الأديب ورهافة حسّه ، وله من الشواهد الشعرية ما ينبئ عن تمكّنه من العربية.
من معالجاته في المتن التقديم والتعقيب وتوضيح المصطلحات لرواياته.
في الفروع من الكافي : روايات الكليني (فقه سنّة) ، وما كان لتوضيح آية يعدّ تفسيرا روائيا لآيات الأحكام.
دُوّن الكافي بمنهجية علمية وبأُسلوب مبرمج للأُصول الأربعمئة.
تأثير الكليني فيمن خلفه من المحدّثين والفقهاء جليا ومؤّراً .
تنوّعت مصادر إسناده ، فضمّت حتّى الضعفاء والمناوئين، فالحكمة ضالّة المؤن ، وهو ينهج بذلك مبدأ: أنا والآخر.
انطلق الشيخ الكليني أثر ذلك إلى مديات أرحب في الدعوة الإسلامية لتحقيق أُممية الإسلام وعالمية الدعوة.
ص: 123
1. القرآن الكريم
2. الأربعون حديثا ، روح اللّه الخمينى ، دار الكتاب الإسلامي ، تعريب : محمّد الغروي ، الطبعة الخامسة .
3. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ في علم الأُصول ، محمّد بن علي الشوكاني ، مصر : مطبعة البابلي الحلبي ، 1937م .
4. أُصول البحث ، عبدالهادي الفضلي ، قمّ : مؤسّسة دار الكتاب الإسلامي .
5. أُصول الحديث (علومه و مصطلحه) ، محمّد عجاج الخطيب ، بيروت : دار الفكر ، الطبعة الثانية ، 1971م .
6. أضواء على السنّة المحمّدية ، محمود أبو رية .
7. أعيان الشيعة ، محسن الأمين العاملي ، بيروت : مطبعة الإتقان والإنصاف .
8. باب مدينة علم الفقه ، علي كاشف الغطاء ، بيروت : مطبعة الزهراء ، الطبعة الاُولى ،
1985 م .
9. بحوث في تاريخ السنّة المشرّفة ، أكرم العمري ، بغداد : مطبعة الإرشاد ، الطبعة الثانية ، 1972 م .
10. تجارب الأُمم ، أبو علي ابن مسكويه ، مصر : مطبعة شركة التمدن ، 1914م .
11. التهذيب ، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، تحقيق : حسن الموسوي الخرسان ،
النجف الأشرف : مطبعة النعمان ، الطبعة الثانية ، 1962م .
12. دروس في المناهج والاتّجاهات التفسيرية للقرآن ، محمّد علي الرضائي الإصفهاني ، قمّ : المركز العالمي للدراسات الإسلامية .
ص: 124
13. رجال النجاشي ، أبو العبّاس النجاشي ، الهند - بمباي ، 1317 ه .
14. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، محمّد بن مكي العاملي (الشهيد الثاني) ، تحقيق : جامعة النجف الدينية ، الطبعة الاُولى ، 1386 ه .
15. الشافي في شرح أُصول الكافي ، المظفّر ، النجف : مطبعة الغري الحديثة ، 1958م .
16. علوم الحديث الشريف ضمن كتاب حضارة العراق ، مجموعة من الباحثين العراقيين ، 1980م .
17. علوم الحديث ونصوص من الأثر ، قحطان عبدالرحمن الدوري و رشدي عليان وكاظم
الراوى ، بغداد : مطبعة جامعة بغداد ، 1980م .
18. الفتاوى الواضحة ، الشهيد محمّد باقر الصدر .
19. لسان العرب ، ابن منظور جمال الدين بن مكرم ، بيروت : دار صادر ، 1956م .
20. محاضرات في أُصول الفقه الجعفري ، محمّد أبو زهرة ، مصر : دار الثقافة العربية للطباعة ، 1377 ه .
21. مختار الصحاح ، الرازي ، بيروت : دار صادر ، 1976م .
22. مشروعية تدوين الحديث ، محمود المظفّر ، بحث في مجلّة كلّية الفقه النجف الأشرف ، العدد الأوّل ، 1979م .
23. معالم العلماء ، رشيد أبو جعفر ابن شهر آشوب ، بيروت : دار المعرفة ، الطبعة الثانية ،
1975م .
24. المقالات والفرق ، سعد بن عبداللّه الأشعري ، طهران : مطبعة حيدر ، 1963م .
25. المقنعة في الفقه ، الشيخ المفيد ، مصورة مخطوطة .
26. مناهج البحث العلمى ، عبدالرحمن بدوي ، الكويت : وكالة المطبوعات ، الطبعة الثالثة ،
1977 م .
27. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، 1388 ه .
ص: 125
ص: 126
هو فخر الشيعة، وتاج الشريعة، ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني(2) الرازي، الشيخ الجليل القدر، العارف بالأخبار، أوثق الناس بالحديث وأثبتهم، الكافل لأيتام آل محمّد عليهم السلام بكتابه الكافي ، الذي صنّفه في عشرين سنة، المجدّد لمذهب الإمامية على رأس المئة الثالثة. وله غير كتاب الكافي كتب أُخرى ، منها : رسائل الأئمّة ، ينقل عنه السيّد رضي الدين بن طاووس في كشف المحجّة .
مات رحمه الله ببغداد سنة تسع وعشرين وثلاثمئة، سنة تناثر النجوم، وصلّى عليه محمّد بن جعفر الحسيني أبو قيراط، ودُفن بباب الكوفة، قبره إلى الآن مزار معروف وعليه قبّة عظيمة.
ص: 127
مشايخ الكليني قدس سره المذكورون في أوّل أسانيده المحكي في تنقيح المقال(1) عن المحقّق البهائي في بعض فوائده ، عدّة :
الأوّل : محمّد بن يحيى العطّار (أبو جعفر العطّار القمّي) .
الثانى : أحمد بن إدريس (أبو علي الأشعري) .
الثالث : محمّد بن إسماعيل (قال المامقاني : هو البرمكي كما حقّقناه) .
الرابع : حسين بن محمّد الأشعري (أبو عبد اللّه ، وجدّه عمران بن أبي بكر الأشعري القمّي) .
الخامس : علي بن إبراهيم بن هاشم (أبو الحسن القمّي ، سيُذكر حاله إن شاءاللّه) .
السادس : داوود بن كورة (وهو أبو سليمان القمّي، سيأتي شرح حاله إن شاءاللّه) .
السابع : علي بن محمّد بن عبد اللّه .
الثامن : الحسين بن الحسن العلوي .
التاسع : أحمد بن محمّد الكوفي .
العاشر : حميد بن زياد .
الحادي عشر : محمّد بن جعفر الكوفي .
الثاني عشر : علي بن موسى الكميداني .
الثالث عشر : أحمد بن عبد اللّه بن أُمَية .
الرابع عشر : أحمد بن محمّد .
لمّا كان استنباط الأحكام الإلهيّة الشرعية التي بها ينتظم أمر العباد في الدين والدنيا والمعاش والمعاد، يتوقّف على الأخبار الواردة في بيانها من صاحب الشريعة، النبيّ
ص: 128
الأكرم أحمد المُختار صلى الله عليه و آله وسلم وأوصيائه المرضيين عليهم صلوات اللّه أجمعين؛ لأنّها أحد الأدلّة بل أعظمها، فلذا يجب على الفقيه المُتصدّي لاستنباطها الاعتناء التامّ والتوجّه الكامل إلى فهم معانيها ودرك مقاصدها، برعاية القرائن المتّصلة والمنفصلة المغيّرة للمعنى الحقيقي، والنظر إلى معارضتها وترجيح ذي المزيّة منها على غيرها، بالمرجّحات الواردة في مظانّها وغيرهما من الأُمور الدخيلة في فهم المعنى .
وهذا أمر صعب يحتاج إلى ممارسة كثيرة وتتبّع بليغ وذوق سليم، لاسيّما في الأخير منها، فإنّه من أعظم ما أنعم اللّه على بعض عباده، رزقنا اللّه وإيّاكم بمنّه وكرمه، ولابدّ قبل هذا من معرفة أحوال رجال السند من حيث الوثوق بهم وعدمه، فإنّ هذا أهمّ من الأوّل ؛ لأنّه بمنزلة الأصل للبناء، فيجب رعاية استحكامه أكثر ، وإلاّ يسقط الخبر عن الاعتبار ولا يصلح أن يكون مدركاً للفتوى.
ولو كان في سلسلة الطريق مذموم أو مجهول، فلابدّ من مراجعة كتب الرجال والنظر إلى ما ذكره علماؤها في حقّهم من الجرح والتعديل.
ثمّ إنّه لمّا كان أصحّ الأُصول التي بأيدينا (الكتب الأربعة : الكافي ، وكتاب من لايحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار) للمشايخ الثلاثة : أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني، وأبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي، وأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، رضوان اللّه وغفرانه عليهم أجمعين، سيّما كتاب الكافي الذي صرف مؤلّفه الخبير الصدوق غاية جهده مدّة عشرين سنة ، في جمع أخباره وتهذيبها، حتّى يُقال إنّه قال الإمام المنتظر المهدي - روحي وأرواح العالمين له الفداء - في حقّه : «الكافي كافٍ لشيعتنا» .
ولذا فقد اهتمّ كثير من أكابر علماء الإمامية - قُدّس سرّهم - من السابقين واللاحقين على صيانة أحاديثها وقراءتها على المشايخ الذين يتّصلون بأسانيدهم بصاحب الأصل ، وهو متّصل إلى المعصوم سماعاً ، وتحقيق معانيها وشرح معضلاتها، حتّى وضعوا لها شروحاً مفصّلة متقنة، ونقّحوا مصادرها وبيّنوا أحوال
ص: 129
رجالها، فنحن بحمد اللّه مغنون من بركات وجود هذه المشايخ، ومنوّرون من مصابيح أفكار هذه المفاخر، فلا نحتاج إلى إتعاب النفس وصرف الهمّة زيادة على ذلك، خصوصاً في معرفة رجالها .
ولكنّني لمّا رأيت كثيرا ما نحتاج في المسائل الفقهية إلى الاستناد بالأخبار التي دوّن فيها معظم الأُمور والأحكام ، فلا نزال نضطرّ إلى معرفة مشايخ أصحابها ورجال أسانيدها، فجمعت في هذه الوجيزة ما يرتبط بها ، تذكرةً لنفسي ولأكون أحفظ لأحوالهم ؛ لأنّ أثر الكتابة في الحفظ أكثر من القراءة، ومن اللّه التوفيق وعليه التكلان.
ذكر العلاّمة رحمه الله في الفائدة الثالثة من كتابه المسمّى بخلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ما هذا لفظه :
قال الشيخ الصدوق محمّد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في أخبار كثيرة : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، قال : والمراد بقولي : (عدّة من أصحابنا) : محمّد بن يحيى، وعلي بن موسى الكمنداني، وداوود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم.
وقال : كلّما ذكرته في كتابي المشار إليه عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، فهم : علي بن إبراهيم، وعلي بن محمّد بن عبد اللّه بن أُذينة، وأحمد بن عبد اللّه بن أُميّة، وعلي بن الحسن.
قال : وكلّما ذكرته في كتابي المشار إليه، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، فهم : علي بن محمّد بن علاّن ، ومحمّد بن أبي عبد اللّه ، ومحمّد بن الحسن ، ومحمّد بن عقيل الكليني(1) .
هذا كلام العلاّمة قدس سره في تلك الفائدة ، ولكن قال المامقاني رحمه الله في التنقيح : روى الكليني عن بعض الثلاثة ؛ أي سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد بن عيسى، وأحمد بن
ص: 130
محمّد بن خالد البرقي ، بتوسّط العدّة(1) ، وصرّح بأسمائهم، تخالف ما نقلناه عن الخلاصة.
ففي كتاب العتق هكذا :
عدّة من أصحابنا، علي بن إبراهيم ، ومحمّد بن جعفر أبو الحسن الأسدي ، ومحمّد بن يحيى، وعلي بن محمّد وهو المعروف بماجيلوية بن عبد اللّه القمّي، وأحمد بن عبد اللّه هو ابن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، وعلي بن الحسين السعدآبادي، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن خالد .
وأيضاً روى بواسطة العدّة عن غير هذه الثلاثة، منه جعفر بن محمّد في باب «النهي عن الاسم من الأُصول»، ومنه سعدبن عبد اللّه في باب «الغيبة» بعد الباب السابق، ومنه الحسين بن الحسن بن يزيد في باب «إنّه ليس شيء من الحقّ في أيدي الناس إلاّ ما خرج من عند الأئمّة عليهم السلام» ، ومنه علي بن إبراهيم على ما حكي عن ثلاث نسخ من الكافي في باب «البطّيخ» من كتاب الأطعمة ، وليس في بعضها الآخر ذلك، بل نقلها بلا واسطة كما هو دأبه.
وربّما اتّفق ذكر العدّة في وسط السنة في باب «من اضطرّ إلى الخمر للدواء» في كتاب الأشربة، ولم ينقل عنه ولا عن غيره المراد بهم، فتقف الرواية ؛ لعدم اليقين.
ثمّ إنّه ذكر في موضع من كتابه: إنّ الكليني رحمه الله ربّما يعبّر في أوّل السند بلفظ «جماعة» ، وقد أكثر منه في كتاب الصلاة عن أحمد بن محمّد مطلقا أو مقيّداً بابن عيسى ، بل قيل : إنّه أكثر من أن يُحصى ، واستظهر بعض أساتيد الفنّ كون المراد بالجماعة هم المراد بالعدّة ، وأنّ أشخاصها أشخاص العدّة ، سواء كان عن ابن عيسى أو عن البرقي أو عن سهل بن زياد ، وإن كان في الأكثر عن الأوّل ، ولعلّه لذا لم يبيّنهم. وأمّا إن روى الجماعة عن غير هذه الثلاثة ، فهم غير معلومين.
وذكر أيضاً في الكتاب المشار إليه أنّه ورد في أسانيد الكافي وغيره الحسن بن
ص: 131
محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان . وقد ورد في عدّة أسانيد التصريح بأسماء المقصودين بقوله : غير واحدٍ ، وهم : جعفر بن محمّد بن سماعة ، والميثمي ، والحسن بن حمّاد ، كما في التهذيب في باب الغرر والمجازفة وغيره.
أقول: ذِكْرُ العدّة والرواية بتوسّطها عن بعض الثلاثة والتصريح بأسماء مغايرة لما في الخلاصة، لا يوجب التنافي بين الكلامين ، ولا احتمال كون أفراد العدّة إذا ذُكرت مجرّدةً غير ما نقل عنه العلاّمة ؛ لأنّه قال :
كلّما ذكرته عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ... إلخ .
فيظهر من قوله : «كلّما» أنّه في مقام إعطاء ميزان كلّي في الموارد التي لم يذكر أسماءهم بالتفصيل ، واقتصر بقوله : «عدّة» وحده ، وهذا لا ينافي أن يروي بتوسّط عدّة أُخرى تغاير أسماؤهم لأسماء هؤلاء عمّن روى عنه بتوسّط العدّة المذكورة مع التصريح بأسمائهم ، مثلما أتى به شاهداً . نعم إن قال في موضعٍ : كلّما ذكرته من؟ عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد مثلاً ، فهم علي بن إبراهيم ، إلى آخر ما ذكره في كتاب العتق، فلا محالة ينجرّ إلى التنافي بين الكلامين. فظهر أنّ المقصود من العدّة إذا ذُكرت مجرّدة هي ما نقل عنه العلاّمة رحمه الله بلا ريب، بخلاف ما اذا فصّل أسماءهم ، فنتّبع ما ذكره .
ص: 132
العِدّة الاُولى(1)
والمراد به محمّد بن يحيى أبو جعفر العطّار ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله في الباب الرابع من كتابه الدراية ، في النوع المتّفق والمفترق (أي المتّفق في الاسم والمفترق في الشخص) :
وكروايتهم عن محمّد بن يحيى مطلقا ، فإنّه أيضاً مشترك بين جماعة، منهم : محمّد بن يحيى العطّار القمّي ، ومنهم : محمّد بن يحيى الخزّاز (بالخاء المعجمة والزاء قبل الألف وبعدها) ، ومحمّد بن يحيى بن سليمان الخثعمي الكوفي، والثلاثة ثقات ، وتميّزهم بالطبقة ، فإنّ محمّد بن يحيى العطّار في طبقة مشايخ أبي جعفر الكليني ، فهو المراد عند إطلاقه في أوّل السند محمّد بن يحيى، والآخران رويا عن الصادق ، فيُعرفان بذلك(2) .
قال النجاشي رحمه الله :
محمّد بن يحيى أبو جعفر العطّار القمّي ، شيخ أصحابنا في زمانه ، ثقة عين ، كثير الحديث ، له كتب ، منها : كتاب مقتل الحسين عليه السلام ، وكتاب النوادر ، أخبرني عدّة من أصحابنا ، عن ابنه أحمد ، عن أبيه بكتبه(3).
ص: 133
وقال المامقاني في التنقيح:
بل وثّقه كلّ من ذكره من الفقهاء رضوان اللّه عليهم ، وميّزه في المشتركات برواية ابنه أحمد والكليني ومحمّد بن الحسن بن الوليد عنه(1).
اختلفوا في ضبط هذه الكلمة ومعناها، قال في التنقيح :
اسم لبلدة قمّ الطيّبة في أيّام الفرس (بضمّ الكاف وفتح الميم وسكون النون) ، فلمّا فتحها المسلمون اختصروا فسمّوها قمّاً .
وقال النجاشي في ترجمة موسى بن جعفر الكميذاني : «إنّها قرية من قرى قمّ(2).
وقال التفرشي :
إنّها اليوم مشهورة بالياء بدل النون ... .(3) إلخ.
وكيف كان ، فلاحاجة لنا في معرفة هذا الاسم لفظه ومعناه ، والتطويل بلا طائل ، وإنّما المهمّ معرفة حاله، فأقول : من الأسف أنّه لم يتعرّض الرجاليون لبيان حاله فيما رأينا من المصادر المعروفة ، فلا نعلم منه أكثر من أنّه كان من العدّة التي روى الكليني رحمه الله عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى .
وروى عنه أيضا أحمد بن أبي زاهر في باب جهات علوم الأئمّة من كتاب الحجّة من المجلّد الأوّل من أُصول الكافي ، والسند هذا :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن علي بن موسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد اللّه ... إلخ(4) .
وأيضاً روى عنه الكليني في الأُصول في كتاب الحجّة، باب أنّ الأئمّة عليهم السلامولاة أمر اللّه ، والرواية هذه :
ص: 134
علي بن موسى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي ، عن النضر بن سويد رفعه ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت له : جُعلت فداك ، ما أنتم ؟ قال : نحن خزّان علم اللّه ، ونحن تراجمة وحي اللّه ، ونحن الحجّة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض(1) .
وأيضاً قال في جامع الرواة:
روى الصدوق في الفقيه عن أبيه ، عنه .(2)
هذا ولكنّ رواية هؤلاء المشايخ لا يكفي في توثيقه، بل لابدّ ممّا يدلّ عليه صريحاً أو بالالتزام القطعي، ومع عدمه لاتُقبل روايته على حسب القاعدة، وإن روى عنه عدل ثقة معتمد عليه. ولا يصغى إلى ما ذكره في التنقيح من أنّه شيخ الإجازة ، وهو غنيّ عن التوثيق .
وإنّ هذا مبنيّ على ما قرّره في الفائدة الرابعة في أوّل الكتاب من تصريح بعض الأجلاّء من هذا الفنّ بعدم الحاجة إلى مراجعة كتب الرجال في معرفة المشايخ الثلاثة وأمثالهم .
واستشهد له بكلام الشهيد الثاني في شرح الدراية من أنّه قال :
تُعرف العدالة الغريزية في الراوي بتنصيص عدلين عليها، وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّدبن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا ، لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ إلى تنصيصٍ على تزكية ، ولا تنبيهٍ على عدالة ؛ لما اشتهر - في كلّ عصر - من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة ، وإنّما يتوقّف على التزكية غير هؤلاء الرواة من الذين لم يشتهروا بذلك ، ككثيرٍ ممّن سبق على هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالباً(3) .
ص: 135
هذه عبارته نقلناها من كتاب شرح الدراية .
وفيه : إنّ هذا الكلام لا يدلّ على ما رامه من عدم الحاجة في توثيق المشايخ الثلاثة إلى نصٍّ بالتوثيق من أصحابه، بل يظهر منه أنّه من كان من المشايخ من زمن الكليني رحمه الله عدالته مشهورة مستفيضة بين الأصحاب ، فلا يحتاج إلى نصٍّ على التزكية.
وحاصله : إنّ معرفة وثاقة الراوي لا يختصّ بتنصيص عدلين، بل ... عدالته بحيث استفاض بين الأصحاب يكفي في ثبوته، والسرّ في ذلك هو أنّ الاشتهار بهذا الحدّ ممّا يوجب الاطمئنان والوثوق بوثاقته، وإلاّ فصرف الاشتهار بدون حصول الاطمئنان لا يكفي في ذلك ، وهذه الشهرة مفقودة في حقّ بعض المشايخ ، مثلما نحن فيه ، فإنّ علي بن موسى الكمنداني لم يشتهر بين الأصحاب وثاقته بحيث يطمئنّ النفس بذلك .
وأيضاً الظاهر أنّ المراد بقوله :
من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب» ، أنّ أوّلهم الكليني ، فمن بعده حتّى ينتهي إلى زمانه ، وليس المراد ما يشمل مشايخ الكليني أيضاً . ويؤيّده قوله :
وإنّما يتوقّف على التزكية غير هؤلاء من الذين لم يشتهروا بذلك ، ككثير ممّن سبق على هؤلاء ، وهم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالباً .(1)
ثمّ نقل كلام ولده صاحب المعالم قدس سره من المنتقى ، وهو على ما رأينا فيه هذا :
الفائدة التاسعة : يروي المتقدّمون من علمائنا رضي اللّه عنهم ، عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم ، وليس لهم ذكر في كتب الرجال ، والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين . ويشكل بأنّ قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتّخاذ أُولئك الأجلاّء - الرجل الضعيف أو المجهول - شيخاً يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به ، ورأيت لوالدي رحمه الله كلاماً في شأن بعض مشايخ الصدوق رحمه الله قريباً ممّا قلناه ، وربّما يتوهّم أنّ في ترك التعرّض لذكرهم في
ص: 136
كتب الرجال إشعاراً بعدم الاعتماد عليهم ، وليس بشيء ، فإنّ الأسباب في مثله كثيرة ، وأظهرها أنّه لا تصنيف لهم ، وأكثر الكتب المصنّفة في الرجال لمتقدّمي الأصحاب ، اقتصروا فيها على ذكر المصنفّين ، وبيان الطرق إلى رواية كتبهم ، ومن الشواهد على ما قلناه ، أنّك تراهم في كتب الرجال يذكرون عن جمع من الأعيان أنّهم كانوا يروون عن الضعفاء ، وذلك على سبيل الإنكار عليهم ، وإن كانوا لا يعدّونه طعناً فيهم ، فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيات من ذكرت عنه ، لم يكن للإنكار وجه ... إلخ .(1)
ولا يخفى عليك ما فيه ؛ لأنّه إن كان المقصود إثبات عدالتهم بذلك، ففيه : إنّ مجرّد الاستبعاد من اتّخاذ هؤلاء الأجلاّء - الرجل المجهول أو الضعيف - شيخاً لا يجعله معلوم الحال ولا يثبت عدالته ووثاقته، فلا يجوز لنا الحكم بصحّة الرواية من طريقه ما لم يحرز عدله بالبيّنة أو العلم . نعم ، إن علمنا أنّ من دأبه عدم الرواية إلاّ من الثقة أو تعهّد نفسه بذلك ، فلا إشكال حينئذٍ من ثبوت العدالة بمجرّد نقله عنه ، كما صرّح بذلك في محكي كلام الرواشح ، حيث قال:
رواية الثقة الثبت عن رجل سمّاه ، تعديل أم لا؟ قال في شرح العضدي : إنّ فيه مذاهب ، أوّلها : تعديل ؛ إذ الظاهر أنّه لا يروي إلاّ عن عدل . الثاني : ليس بتعديل ؛ إذ كثيرا نرى من يروي ولا يذكر ممّن يروي . وثالثها - وهو المختار - : إنّه إن علم من عادته أنّه لا يروي إلاّ عن عدل فهو تعديل ، وإلاّ فلا(2) .
انتهى ما أردناه .
ولكن لم يتحقّق هذا المعنى في حقّ المشايخ الثلاثة ، وإن كان المراد أنّ حديثه معتبر وإن لم يكن عادلاً ، وأنّه صادق القول محلّ الاطمئنان والوثوق من جهة نقله،
ص: 137
ففيه أيضاً أنّه لا يكون دليلاً عليه؛ لإمكان أن يكون قبول الرواية بواسطة القرائن الموجودة عندهم المختفية علينا ، وإكثار الرواية عنه وإن كان يوجب الظنّ بذلك ، ولكن أوّلاً يحصل معه الاطمئنان غالباً، (والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً) .
ثمّ إنّا لا نتوهّم أنّ عدم التعرّض لأحوالهم مشعر بعدم الاعتماد عليهم ، بل السبب في ذلك أنّهم لا يعرفونهم ، وإلاّ إن كان حالهم معلوماً عندهم بالضعف أو الوثوق لذكروهم كما ذكروا غيرهم ، ولا موجب لعدم التعرّض لذكرهم . وتوهّم كون ذلك من جهة أنّهم غير مصنّفين وأنّ أكثر الكتب المصنّفة في الرجال اقتُصر فيها على ذكر أصحاب الكتب، مدفوع بأنّ بعض الكتب وُضِع لذكر أحوال الرجال من غير النظر إلى أنّهم أصحاب تصنيف أم لا ، كرجال شيخ الطائفة رحمه الله (1) وأبوالعبّاس ،(2) وإن كان كثيرا ما يذكر المصنّفين ، ولكن ربما يتعرّض لشرح حال غيرهم من الرواة، فلو كانوا معروفين عندهم لضبطوا حالهم كما ضبطوا غيرهم .
وأمّا ما ذكره شاهداً ، ففيه أوّلاً : إنّ إنكار الرجاليين على بعض الأعيان(3) لا يوجب اختصاصهم بالرواية عن الضعيف ؛ لأنّهم ليسوا في مقام الحصر . وثانياً : إنّهم أنكروا على من كان يروي عن الضعفاء ، لا من يروي عمّن هو مجهول(4) عندهم ، إذ لعلّه كان من العدول عنده.
وهاهنا كلام للمحقّق البهائي نقله في التنقيح ، قال فيه: قال الشيخ البهائي رحمه الله في محكيّ مشرق الشمسين :
قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدحٍ ولا قدح، غير أنّ أعاظم علمائنا المتقدّمين قدّس اللّه أرواحهم قد اعتنوا
ص: 138
بشأنه وأكثروا الرواية عنه، وأعيان مشايخنا المتأخّرين طاب ثراهم قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها، والظاهر أنّ هذا القدر كافٍ في حصول الظنّ بعدالته(1) .
ثمّ ذكر أنّ من ذلك أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، والحسين بن الحسن بن أبان ، وأبو الحسين علي بن أبي جيد. قال :
فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب ، لنا ظنّ بحسن حالهم وعدالتهم ، وقد عددت حديثهم في الحبل المتين وفي هذا الكتاب ، جرياً على منوال مشايخنا المتأخّرين ، ونرجو من اللّه سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقاً للواقع .(2)
قلت: كلامه رحمه الله في غاية الجودة والمتانة من حيث حصول الظنّ بحسن حالهم وعدالتهم ، مع تصحيح بعض المشايخ روايات وقعوا في سندها ، ولكنّ الحكم بصحّة(3) هذه الروايات بمجرّد حصول الظنّ بعدالتهم مبنيّ على إثبات أنّ الظنّ بالعدالة يكفي في التوثيق ولا طريق إلى إثباته ؛ ولأنّه لا يغني من الحقّ شيئاً.
والعجب من المحقّق الداماد حيث اكتفى في ثبوت التوثيق بمجرّد الترضية عنهم، حيث قال في الرواشح السماوية على ما حكى عنه صاحب التنقيح :
إنّ للصدوق أشياخاً كلّما سمّى واحداً منهم في سند الفقيه، قال : رضي اللّه عنه ، كجعفر بن محمّد بن مسرور، فهؤلاء أثبات أجلاّء، والحديث من جهتهم صحيح ، نصّ عليهم بالتوثيق أو لم ينصّ(4) .
مع إنّه لم نرَ أحداً من علماء هذا الفنّ أن يقول مجرّد الترضية عن رجلٍ إذا صدر عن الثقة: توثيق.
إن قلت: لا مناص من توثيق رجال الصدوق الذين وقعوا في أسناد روايات كتاب من لا يحضره الفقيه وتصحيح رواياته ؛ لأنّه قال في ضمن خطبة الكتاب:
ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي
ص: 139
به، وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي - تقدّس ذكره وتعالت قدرته - ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل وإليها المرجع(1) .
وهذا - أيّ العمل بهذه الروايات - توثيق لرجاله ، فكما أنّه إن قال : «فلان ثقة» حكمنا بعدالته ، فكذا إن رتّب آثار الصحّة على روايته، فهذا توثيق فعلي بمنزلة التوثيق القولي .
قلت: مجرّد العمل بروايته لا يدلّ على توثيق رجال سنده ؛ لأنّه يحتمل أن يكون قبوله للخبر وترتيب آثار الصحّة عليه بواسطة وجود قرائن عنده مفقودة عندنا .
وكذا إن قلت: قال الكليني في خطبة كتاب الكافي في جواب من طلب منه كتاباً كافّاً يجمع (فيه) من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام :
قد يسّر اللّه - وله الحمد - تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت .(2)
فهذا الجواب يدلّ على كون روايات الكتاب صحيحة عنهما، وهذا مستلزم لتوثيق رجاله عملاً.
قلت: الجواب: والحاصل إنّا إن لم نقل بأنّ ثبوت العدالة يحتاج إلى تخصيص العدلين، لا نقول بحصول التوثيق بمجرّد رواية الثقة عنه، نعم قبول رواياته واندراجه في الصحيح حكماً بواسطة وجود بعض القرائن ، مثل استشهاد القدماء بها في الحكم، وغير ذلك ممّا يوجب الاطمئنان بصدوره، أمرٌ آخر.
هو الذي بوّب كتاب النوادر لأحمد بن عيسى ، وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب السرّاد على معاني الفقه ، له كتاب الرحمة في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحجّ(1) .
وعدّه الشيخ في رجاله ممّن لم يروِ عنهم ،(2) وكذا في الفهرست ،(3) بزيادة قوله :
وله كتاب الرحمة مثل كتاب سعد بن عبد اللّه ، على ما نقل في التنقيح» .
وقال المامقاني فيه (أي تنقيح المقال) :
لا شبهة في كونه إمامياً، وكونه من مشايخ الكليني ، مدح ، معتدّ به . ثمّ قال: فهو إن لم يكن ثقة فلا أقلّ في أعلى درجات الحسن، فتعجّب من عدّه في الحاوي في قسم الضعفاء ومن إهمال ذكره في الوجيزة .
أقول: لم أجد ذكره في الخلاصة أيضاً ، لا في القسم الأوّل ولا في القسم الثاني، وعبارة «مَن ذَكَره» ، خالية عن مدحٍ أو توثيقٍ كما ترى، ومجرّد كونه إماميا لا يدخله في الممدوحين ما لم يصرّحوا عليه بالمدح، خصوصاً مع ما رأيت من إهمال ذكره في الوجيزة والخلاصة وعدّه من الضعفاء في الحاوي ، فالأقوى التوقّف فيه وإلحاق حديثه بالموثّق على أحد معنييه؛(4) لأنّه غير ممدوح ولا مذموم ، إذ لا يمكن الركون في ذمّه بمجرّد عدّه في قسم الضعفاء مع عدم نقل ما يوجبه من الشيخ والنجاشي قدّس سرّهما.
هو ثقة ، جليل القدر، فقيه في أصحابنا، كثير الحديث. قال النجاشي:
أحمد بن إدريس بن أحمد، أبو علي الأشعري القمّي، كان ثقة ، فقيهاً في أصحابنا،
ص: 141
كثير الحديث، صحيح الرواية، له كتاب نوادر ، أخبرني عدّة من أصحابنا إجازة عن أحمد بن جعفر بن سفيان عنه . ومات أحمد بن إدريس بالقرعاء سنة ستّ وثلاثمئة من طريق مكّة على طريق الكوفة(1).
وفي التنقيح :
قال في الفهرست: كان ثقةً في أصحابنا، فقيهاً، كثير الحديث ، صحيح الرواية ، وله كتاب النوادر، كتاب كثير الفوائد، عدّه الشيخ في رجاله تارةً من أصحاب العسكري عليه السلام ، واصفاً له بالمعلّم ، وقال : لحقه - يعني العسكري عليه السلام - ولم يروِ عنه . وأُخرى في باب من لم يروِ عنهم بقوله : أحمد بن إدريس القمّي الأشعري ، يُكنّى أبا علي ، وكان من القوّاد، روى عنه التلَّعُكبري ، قال : سمعت منه أحاديث يسيرة في دار ابن همام ، وليس لي منه إجازة ، وميّزه في مشتركات الطريحي والكاظمي برواية أحمد بن جعفر بن سفيان البَزَوفَري والتلَّعُكبري عنه ، وزاد في الثاني التمييز برواية محمّد بن يعقوب الكليني ، والحسن بن حمزة العلوي عنه ، وبروايته عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن أحمد بن يحيى ومحمّد بن الحسن بن الوليد .(2)
وقال العلاّمة بعد توثيقه والثناء عليه : «أعتمد على روايته» .
ثقة في الحديث ، معتمد عليه . قال النجاشي بعد عنوانه بما ذكرنا بزيادة القمّي بعد أبو الحسن:
ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر ، وصنّف كتباً وأضرّ في وسط عمره . وله : 1 - كتاب التفسير ، 2 - كتاب الناسخ والمنسوخ ، 3 - كتاب قرب الإسناد ، 4 - كتاب الشرائع ، 5 - كتاب الحيض ، 6 - كتاب التوحيد والشرك ، 7 -كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، 8 - كتاب المغازي ، 9 - كتاب الأنبياء ، 10 - رسالة
في معنى هشام ويونس ، 11 - جوابات مسائل سأله عنها محمّد بن بلال، كتاب
ص: 142
يعرف بالمشذّر ، واللّه أعلم ، أنّه مضاف إليه . أخبرنا محمّد بن محمّد وغيره عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبيد اللّه ، قال : كتب إليّ علي بن إبراهيم بإجازة سائر حديثه وكتبه .(1)
وفي التنقيح:
ووثّقه في الوجيزة والبلغة والمشتركاتين وغيرها أيضا . وعن إعلام الورى : إنّه من أجلّ رواة أصحابنا . وقال في الفهرست: علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، له كتب ، منها كتاب التفسير ، وكتاب في الناسخ والمنسوخ ، وكتاب المغازي ، وكتاب الشرائع ، وكتاب قرب الإسناد ، وزاد ابن النديم كتاب المناقب وكتاب اختيار القرآن ، أخبرنا بجميعها جماعة ، عن أبي محمّد الحسن بن الحمزة العلوي الطبرسي ، عن علي بن إبراهيم ، وأخبرنا محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسين وحمزة بن محمّد العلوي ومحمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، إلاّ حديثاً واحداً ، استثناءً من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير ، وقال : لا أرويه .
وروى أيضاً حديث تزويج المأمون أُمّ الفضل من محمّد بن علي عليهماالسلام ، ورويناه بالإسناد الأوّل، وقال فيه: لم أقف على تاريخ وفاته ، ويُستفاد ممّا مرّ نقله في العيون في ترجمة حمزة بن القاسم من ولد أبي الفضل عليه السلام من روايته عن علي هذا سنة سبع وثلاثمئة ، هو حياته في ذلك الوقت وموته بعده. ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره السيّد صدر الدين في تعليقته على منتهى المقال من درك الرجل الرضا عليه السلام اشتباه ؛ لأنّه توفّي سنة اثنتين ومئتين ، ولا تقضي العادة ببقاء عليّ هذا من ذلك الزمان مع بلوغه أقلاًّ إلى التاريخ المزبور، مع أنّا لم نقف على رواية واحدة عن الرضا .(2)
وأمّا الذي روى عنه هذه العدّة فهو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي؛
قال النجاشي رحمه الله :
أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن الأحوص(3) بن السائب بن
ص: 143
مالك بن عامر الأشعري ، من بني ذُخْران(1) بن عوف بن الجُماهِر(2) بن الأشعر ، يُكنّى أبا جعفر، وأوّل من سكن قمّ من آبائه سعد بن مالك بن الأحوص، وكان السائب بن مالك وفد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم وأسلم ، وهاجر إلى الكوفة وأقام بها، وذكر بعض أصحاب النسب أنّ في أنساب الأشاعرة أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن هاني بن عامر بن أبي عامر الأشعري، واسمه عبيد وأبوعامر ، له صحبة، وقد روي أنّه لمّا هزم هوازن يوم حنين عقد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلملأبي عامر الأشعري على خيل فقُتل، فدعا له ، فقال: اللّهمّ أعط عبدك عبيدا أبا عامر ، واجعله في الأكبرين يوم القيامة .
قال الكشّي عن نصر بن الصبّاح: ما كان أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عن ابن محبوب ؛ من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة الثمالي، ثمّ تاب ورجع عن هذا القول .
قال ابن نوح: وما روى أحمد عن ابن المغيرة ولا عن الحسن بن خرزاذ . وأبو جعفر رحمه الله شيخ القمّيين ووجههم وفقيههم غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقي السلطان ، ولقي الرضا عليه السلام ، وله كتب، ولقي أبا جعفر الثاني عليه السلام ، ولقي أبا الحسن العسكري عليه السلام ، فمنها : 1 - كتاب التوحيد، 2 - كتاب فضل النبي صلى الله عليه و آله وسلم، 3 - كتاب المتعة، 4 - كتاب النوادر، وكان غير مبوّب فبوّبه داوود بن كورة، 5 - كتاب الناسخ والمنسوخ، 6 - كتاب الأظلّة، 7 - كتاب المسوخ، 8 - كتاب فضائل العرب .
قال ابن نوح : ورأيت له عند الديبلي كتاباً في الحجّ ، أخبرنا بكتبه الشيخ أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه ، و أبو عبد اللّه بن شاذان، قالا: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه عنه، وقال لي أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح: أخبرنا بها أبو الحسن بن داوود ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ومحمّد بن
ص: 144
يحيى وعلي بن موسى بن جعفر وداوود بن كورة وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بكتبه(1) .
وقال الطوسيفي الفهرست بعد ترجمته:
وأبو جعفر ، شيخ قمّ ووجهها وفقيهها غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذى يلقي السلطان بها ، ولقي أبا الحسن الرضا عليه السلام . وذكر جملة من كتبه ، ثمّ قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدّة من أصحابنا ، منهم الحسين بن عبيد اللّه ، وابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، وسعد بن عبد اللّه عنه، وأخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار وسعد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وروى ابن الوليد المبوّبة ، عن محمّد بن يحيى والحسن بن محمّد بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمّد .(2)
وقال في رجاله في ذكر أصحاب الرضا عليه السلام :
أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي ، ثقة، له كتب . وذكره في أصحاب أبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد عليه السلام قائلاً : أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، من أصحاب الرضا عليه السلام (3) .
وقال العلاّمة رحمه الله في محكي الخلاصة بعد توصيفه بما في الفهرست(4) :
... وأبا جعفر الثاني وأبا الحسن العسكري عليهماالسلام: وكان ثقة، وله كتب ذكرناها في الكتاب الكبير .(5)
وفي التنقيح :
وعن الصدوق في كتاب الفقيه مدحه ووصفه إيّاه بالفضل والجلالة، وقد وثّقه الشهيد
ص: 145
الثاني رحمه الله في الدراية ، وولده الشيخ حسن في محكي المنتقى ، فذكر توثيق عدّة من الرجاليّين ، ثمّ قال : وفي الحاوي مع أنّ ديدنه التشكيك غالباً، أنّ عبارة النجاشي والفهرست يفيدان بظاهرهما التوثيق، مضافاً إلى توثيق الشيخ رحمه الله في كتاب الرجال ، ووصف العلاّمة رحمه الله حديثه بالصحّة .(1)
فتلخّص: إنّ هذه العدّة وإن كان حال بعض أفرادها غير معلوم ، ولكنّ أكثرهم من الثقات الأخيار والأعيان الأطياب ، الذين لم يشكّ في جلالة قدرهم وعظم شأنهم أحد، وكذا حال المرويّ عنه ابن عيسى رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين. فلا ريب ولا إشكال في صحّة السند إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، فلينظر حال من كان قبله في الثقة والضعف.
ص: 146
أشخاصها أربعة . قال السيّد الطباطبائي:
وعدّة البرقي وهو أحمد *** علي بن الحسن وأحمد
وبعد ذين بن أُذينة علي *** وابن لإبراهيم واسمه علي
وهو المذكور في العِدّة الاُولى ؛ وهو علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، على الظاهر القوي، بل لا يحتمل خلافه ؛ لأنّه لم يذكر في طبقة مشايخ الكليني على ما نقلنا عن المحقّق البهائي . ويظهر من صاحب عين الغزال(1) غيره ، مع أنّه عدّ من مشايخه الذين روى عنهم بلا واسطة ، وأُجيز منهم في قراءة الحديث خمساً وثلاثين رجلاً ليس فيهم ابن إبراهيم إلاّ علي بن إبراهيم بن هاشم ، ومن البعيد غايته أن يكون في طبقة مشايخه ابن إبراهيم آخر لم يطّلع عليه هؤلاء، مع أنّهم بصدد جمع مشايخه ، بل وخفي على جميع الرجاليّين ؛ لأنّه إن ذكر في أصل رجالي لنقل إلينا بواسطة الذين جمعوا الأقوال ، مع أنّه لم يذكر هذا الاسم في الرجال إلاّ موصوفاً بصفة غالباً بها يمتاز عمّن عداه ، ومع ذلك بعضهم لم يكونوا في عصره ، مثل: علي بن إبراهيم الجواني وغيره، وأيضا لم يذكروا وقوع من كان بهذا الاسم في إسناد كتاب الكافي ، فضلاً عن أن يكون في طبقة مشايخه، مع أنّهم تفحّصوا إسناد الروايات كلّها ، ولو كان لذكروا كما ذكروا الذين وقعوا في طريق مشايخ أُخر غير الكليني .
نعم ، قال في التنقيح في ترجمة علي بن إبراهيم الجعفري :
ص: 147
لم أقف فيه إلاّ على رواية الكليني ، عن محمّد بن يحيى عنه ، في مواضعٍ من الكافي، منها باب الخلّ من كتاب الأشربة ، وروى في باب الصلاة على المصلوب من الكافي عن الرضا عليه السلام ، ولم يظهر حاله .(1)
ولكن هذا لا يوجب اشتباه الرجل بغيره ؛ لأنّه لا يكون في طبقة مشايخه، مع أنّ الكليني لم يذكره مجرّداً حتّى يلتبس بغيره، بل موصوفاً بالجعفري ، ومع ذلك كلّه أنّا لم نجد في باب الصلاة على المصلوب من الكافي من علي بن إبراهيم الجعفري عيناً ولا أثراً ؛ لأنّ في هذا الباب ثلاث روايات ، ولا يكون في سند واحد منها هذا الرجل، بل وقع في سند الثانية منها أبو هاشم الجعفري هكذا:
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري .
وليس في أكثر النسخ كلمة عن أبيه على ما في الحاشية ، ومع ذلك لا يحتمل كون علي بن إبراهيم الواقع في أوّل السند هو الجعفري؛ لأنّه قال: يروي عنه بواسطة محمّد بن يحيى، ولا واسطة بينه وبين علي بن إبراهيم في هذا السند، فيكون هو ابن هاشم القمّي الذي وقع في أوّل أكثر أحاديث الكافي، ولا أدري كيف وقع منه هذا الاشتباه البيّن، فمثل هذا يوجب وهن الاعتقاد بالنقليات ، وإلزام النفس بمراجعة المصادر ، عصمنا اللّه من الزلل في القول والفعل .
والمتحصّل من جميع ذلك أنّه هو ابن الهاشم القمّي الثقة ، الذي أسلفنا ترجمته ، فلا نُطيل بإعادتها .
والظاهر أنّه هو علي بن محمّد بن عبد اللّه القمّي ، ويشهد بذلك ما وقع من الكليني في الباب التاسع من كتاب العتق من تفسير العِدّة التي روى بواسطتهم الحديث المذكور في هذا الباب ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، فإنّه قال على ما في خاتمة
ص: 148
المستدرك:
عدّة من أصحابنا؛ علي بن إبراهيم ومحمّد بن جعفر ومحمّد بن يحيى وعلي بن محمّد بن عبد اللّه القمّي وأحمد بن عبد اللّه وعلي بن الحسن جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ... إلخ(1) .
وكيف كان ، فالرجل غير معروف عندهم ، قال في التنقيح:
لم أقف فيه إلاّ على رواية الكليني رحمه الله ، عنه عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعنه عن
أبيه ، عن محمّد بن عيسى، وعنه عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد البرقي وإبراهيم بن إسحاق الأحمر والسيّاري ، وحاله مجهول .(2)
وقال في محكيّ توضيح المقال عند ذكر عدّة الكليني:
وبقي شخصان آخران من عدّة البرقي ، أحدهما : أحمد بن عبد اللّه بن أُميّة ، وثانيهما : علي بن عبد اللّه بن أُذينة ، ولم نجدهما في كتب الرجال .(3)
إن قلت : قد نقلتم من التنقيح في أوّل الرسالة ما يدلّ على أنّ عليّ بن محمّد بن أُذينة الذي وقع في عدّة البرقي هو ابن بنته ، أي علي بن محمّد المعروف بماجيلوية ، الذي صرّح العلاّمة بأنّه ثقة، فاضل ، فقيه، أديب، حيث نقل عن الكليني في كتاب العتق من الكافي تفسير العدّة التي رويت عن ابن خالد هكذا:
عدّة من أصحابنا، علي بن إبراهيم ، ومحمّد بن جعفر أبو الحسن الأسدي ، ومحمّد بن يحيى ، وعلي بن محمّد وهو المعروف بماجيلوية بن عبد اللّه القمّي ، وأحمد بن عبد اللّه هو ابن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، وعلي بن الحسين السعدآبادي جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد .
مضافاً إلى أنّه لا يكون في طبقة مشايخه علي بن محمّد بن عبد اللّه متعدّداً وينطبق عليه .
ص: 149
قلت: لا أدري من أين أخذ هذا التفسير، مع أنّه لم أرَ منه أثر في هذا الكتاب على ما لاحظت نسختين من الكافي، ففي أحدهما ذكر السند هكذا:
عدّة من أصحابنا، عن علي بن إبراهيم ، ومحمّد بن جعفر ، ومحمّد بن يحيى ، وعلي بن محمّد بن عبد اللّه القمّي ، وأحمد بن عبد اللّه ، وعلي بن الحسين جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة .
فإنّ الظاهر منه كما ترى أنّه رحمه الله نقل عن عدّة من أصحابه الذين لا نعرفهم ، عن هؤلاء المذكورين في السند ، ولم يفسّر أسماء العدّة. سلّمنا أنّ كلمة «عن» غلط وقع من النسّاخ ، وأنّ السند مطابق لما نقلنا عن المستدرك في الصفحة السابقة ، وأنّ هذا تفسير منه للعدّة، ولكن لم يذكر أنّ علي بن محمّد بن عبد اللّه هو ابن ماجيلوية المعروف، فلعلّ تفسيره هذا الرجل بابن ماجيلوية، تفسير على حسب ظنّه، وفي الثاني أسقط التفسير رأسا ولم يذكر أسماءهم، بل يكون مثل سائر الأسناد؛ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد.
والحاصل ، إنّي لم أتحصّل عاجلاً ما يشخّص الرجل ويعيّنه وما يعطي الوثوق والاطمئنان بحاله، فهو غير معروف ، ونرجو أن يظهر لنا حاله آجلاً، وأن يقوّى في النظر، أن يكون هو ابن بنت محمّد بن خالد؛ لما ذكرنا أنّه لم يكن متعدّداً من كان بهذا الاسم في طبقة مشايخه.
والحاصل ، إنّ كون اسم هذا الرجل أحمد بن عبد اللّه مسلّم لا إشكال فيه ، إنّما الاختلاف في اسم جدّه ، فما نقله في خاتمة المستدرك في تفسير العدّة عنها مكان هذا الشخص، علي بن محمّد بن عبد اللّه ، غلط صريح لا مأخذ له، وكيف كان ، فهو غير معروف بين أصحاب الرجال ، فلم يتعرّض النجاشي ولا العلاّمة لحاله ، بل لا يوجد في كتب الرجال منه أثر كما سمعت من محكي توضيح المقال .
إن قلت: لعلّه ابن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي ، كما نقل في التنقيح تفسيره الكليني بذلك في كتاب الطلاق.
قلت: قد عرفت أنّ هذا التفسير غير موجود في هذا الكتاب، مضافاً إلى أنّه قد سقط في بعض النسخ أسماء العدّة أيضاً، مع أنّ هذا الشخص المفسّر به أيضا غير مذكور فيما رأينا.
والحاصل : إنّ الرجل مجهول الحال ، فتقف الرواية به، ما لم ينضمّ إليه ثقة في درجته.
قال في محكيّ توضيح المقال في مقام عدّ عدّة البرقي:
والثاني : علي بن الحسن، على ما وجد في بعض نسخ الخلاصة ، وهو بهذا العنوان مشترك بين ثقات ومجاهيل، ولا شاهد على كون المعدود من العدّة أحد الثقات أو المجاهيل ، بل الظاهر إباء طبقة الجميع عن طبقة العدّة، ومن هنا قال بعض أجلاّء العصر: لا يبعد أن يكون ذلك من تصرّف النسّاخ ، وأنّه علي بن الحسين مصغّراً ، يعني علي بن الحسين السعدآبادي(1) .
قلت: والظاهر أنّه كذلك ، وسيأتي ما يرتبط بعلي بن الحسين السعدآبادي فانتظره.
هذا ما تيسّر لنا في شرح أحوال العدّة الثانية، والخبر صحيح من جهتهم ؛ لوجود
ص: 151
علي بن إبراهيم فيها وهو الثقة.
وأمّا الّذي روى عنه هذه العدّة فهو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، ثقة في نفسه، إلاّ أنّه يروي عن الضعفاء .
قال النجاشي:
أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علي البرقي، أبو جعفر، أصله كوفي ، وكان جدّه محمّد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد عليه السلام ، ثمّ قتله ، وكان خالد صغير السنّ ، فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق روذ ، وكان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء ، واعتمد المراسيل، وصنّف كتباً، منها: المحاسن وغيرها ، فعدّ ما يشتمل عليها من الكتب الكثيرة . ثمّ قال : هذا الفهرست الذي ذكره محمّد بن جعفر بن بطّة من كتب المحاسن .
وذكر بعض أصحابنا أنّ له كتباً أُخر ، منها : كتاب التهاني، كتاب التعازي، كتاب أخبار الأُمم. أخبرنا بجميع كتبه الحسين بن عبيد اللّه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد أبو غالب الزراري، قال: حدّثنا مؤدّبي علي بن الحسين السعدآبادي أبو الحسن القمّي ، قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبد اللّه بها .
وقال أحمد بن الحسين رحمه الله في تاريخه: توفّي أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي في سنة أربع وسبعين ومئتين. وقال علي بن محمّد ماجيلوية: توفّي سنة ثمانين ومئتين(1) .
وقال الشيخ في ضمن ترجمته:
وكان ثقة في نفسه، غير أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل، وصنّف كتباً كثيرة. ثمّ قال بعد سرد كتبه: أخبرنا بهذه الكتب كلّها وبجميع رواياته عدّة من أصحابنا، منهم: الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد ، وأبو عبد اللّه
الحسين بن عبيد اللّه، وأحمد بن عبدون ، وغيرهم ؛ عن أحمد بن محمّد بن سليمان الرازي ، قال : حدّثنا مؤدّبي علي بن الحسين السعدآبادي أبو الحسن القمّي، قال : حدّثنا أحمد بن عبد اللّه ابن بنت البرقي، قال : حدّثنا جدّي أحمد بن محمّد،
ص: 152
وأخبرنا هؤلاء إلاّ الشيخ أبا عبد اللّه ، وغيرهم ، عن أبي المفضّل الشيباني ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، بجميع كتبه ورواياته، وأخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، بجميع كتبه ورواياته(1) .«
وقال العلاّمة بعد عنوانه بمثل ما عنونه النجاشي :
منسوب إلى برقة قمّ ، جعفر، أصله كوفي ، ثقة ، غير أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل.
قال ابن الغضائري: طعن عليه القمّيون وليس الطعن فيه ، وإنّما الطعن فيمن يروي عنه ، فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ، على طريقة أهل الأخبار . وكان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قمّ ثمّ أعاده إليها واعتذر إليه. وقال: وجدت كتاباً فيه وساطة بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد، ولمّا توفّي مشى أحمد بن محمّد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً ؛ ليبرئ نفسه ممّا قذفه به. وعندي أنّ روايته مقبولة(2) .
وقال في التنقيح، بعد ذكر توثيق النجاشي والشيخ والعلاّمة:
ووثّقه ابن داوود والمجلسي في الوجيزة ، والبحراني في البلغة ، والطريحي والكاظمي المشتركاتين، وهو المحكي عن مشرق الشمسين ، ومجمع المولى عناية اللّه ، ومجمع الفائدة للأردبيلي ، وغيرها، وهو ظاهر الحاوي ، حيث ذكره في الفصل الأوّل المعدّ لعدّ الثقات ، ونقل كلمات النجاشي والشيخ والعلاّمة ولم يلحقها بغمزٍ أو تأمّل، كما هي عادته في كثير من الثقات .(3)
والحاصل ، إنّ الناظر بعين الإنصاف في كلمات مهرة الفنّ لا يتأمّل في وثاقته وجلالته، خصوصاً مع ما صنع به أحمد بن محمّد بن عيسى من الاعتذار والمشي فى جنازته حافياً حاسراً ؛ لجبران ما صدر منه ودفع ما يتوهّم في حقّه بسبب ذلك . نعم ، لابد من التأمّل في حقّ من يروي عنه ؛ لأنّه اشتهر بعدم المبالاة فيمن يأخذ عنهم
ص: 153
الحديث، فحينئذٍ لا يعتني بما يوهم كونه موهناً لروايته وضعفاً فى نفسه، وهو أُمور ذُكر عمدتها في التنقيح .
الأوّل: روايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل .
وفيه: إنّ هذا لايضرّ بعدالته ووثاقته ؛ لأنّ صرف الرواية عن الضعيف مع ذكر اسم المروي عنه لا يوجب فسقاً ؛ لعدم التدليس والغرور، وأمّا الاعتماد على المراسيل، فلعلّه اطّلع على قرائن يوجب الاطمئنان بصدورها ، فكان يعتمد عليها، وإن كانت مرسلةً، وأمّا توصيف النجاشي والشيخ بما ذكر ، فلايؤذن بقدحٍ فيه، بل لأجل أن لا يحسن أحد الظنّ بواسطة وثاقة الرجل بالمروي عنه ، فيترك الفحص عن حاله ، فيقبل الخبر اعتماداً عليه ، كما يتّفق في بعض الرواة ، مثل ابن أبي عمير وأمثاله.
الثاني : طعنُ القمّيين فيه .
وفيه : إنّه إن كان سبب ذلك إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى إيّاه عن قمّ، فقد عرفت أنّه أصبح على ما فعل من النادمين، وإن كان غير ذلك فلابدّ من بيانه ؛ لأنّه ربّما يكون شيء سبباً للطعن عندهم ، مع أنّه لا يوجب قدحاً عند آخرين.
الثالث : إنّ الشيخ البهائي رحمه الله قال في سند رواية فيه أحمد بن محمّد بن خالد؛ بتوجّه الطعن من جهة قول النجاشي، إنّ البرقي ضعيف .
وفيه : إنّ كلام النجاشي كما رأيت خال عن ذلك، بل مشتمل على توثيقه ، ولعلّه اشتبه على أحمد هذا بأبيه محمّد بن خالد ، فإنّه ضعيف كما صرّح به النجاشي.
الرابع: إنّه قد وقع(1) في المختلف في غير موضع، إنّ في أحمد قولاً بالقدح والضعف ، وجعل ذلك طعناً في الأخبار التي هو في طريقها .
وفيه: إنّ هذا مخالف لما ذكره في الخلاصة من توثيقه وقبول روايته ، ويمكن أن يكون طعنه في هذه الأخبار من جهة من يروي عنهم أحمد بن محمّد ، لا من جهة نفسه ، وإن كان ينافي قوله: إنّ في أحمد قولاً بالقدح .
ص: 154
والحاصل ، إنّ نصّه بالتوثيق وقبول روايته في الخلاصة التي أعدّها لبيان أحوال الرجال مقدّم على ما يظهر منه في المختلف من عدم قبول روايته.
الخامس: قال في التنقيح :
إنّ الشهيد الثاني رحمه الله في بحث الإرث بالنكاح المنقطع من المسالك قد طعن في صحيحة سعيد بن يسار الوارد بعدم الإرث مطلقا، باشتمالها على البرقي مطلقا ، ويحتمل كونه محمّداً وابنه أحمد . ثمّ قال : ولكنّ النجاشي ضعّف محمّداً . وقال ابن الغضائري : حديثه يُعرف ويُنكر ، ويروي عن الضعفاء ، ويعتمد على المراسيل، وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدّم .
وظاهر حال النجاشي أنّه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجل ، وأمّا ابنه أحمد فقد طعن عليه أيضا ، وقال ابن الغضائري: كان لا يبالي عمّن أخذ ، وإخراج أحمد بن محمّد بن عيسى له من قمّ لذلك ولغيره .(1)
فأجاب عنه بقوله : وهو من مثله لغريب، فإنّك قد سمعت قول ابن الغضائري وأنّه ردّ الطاعنين ، لا أنّه طعن هو، فنسبة الطعن إليه نفسه لم تقع في محلّه، كتوقّف العمل بحديث الرجل بعد توثيق جماعة كثيرة له .
أقول : ونسبة الطعن إلى النجاشي أيضا غريب ؛ لما رأيت من خلوّ عبارته عمّا يدلّ على الطعن فيه.
السادس: قال فيه أيضا :
إنّ الكليني رحمه الله في باب ما جاء في الأئمّة الاثني عشر نقل حديثاً ناطقاً بأنّ الخضر حضر عند أمير المؤمنين عليه السلام وشهد بإمامة الأئمّة الاثني عشر واحداً بعد واحد ، يسمّيهم بأسمائهم ، حتّى انتهى إلى الخلف الحجّة عليهم السلام . قال الكليني رحمه الله : وحدّثني محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبي هاشم مثله، قال محمّد بن يحيى : فقلت لمحمّد بن الحسن: يا أبا جعفر ، وددت أنّ هذا الخبر جاء من غير أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: فقال: لقد حدّثني قبل الحيرة
ص: 155
بعشر سنين . انتهى ما في الكافي .
وقد حكي عن مجمع المقال للمولى عناية اللّه ، أنّه قال بعد ذكر الخبر: إنّ فيه دلالة على أنّ أحمد بن أبي عبد اللّه ، صار متحيّراً أو وقف . انتهى .
وعن الفاضل الأسترآبادي ، مشيراً إلى أنّ هذا يدلّ على أنّ في قلب محمّد بن يحيى بن أحمد بن أبي عبد اللّه شيئاً .(1)
أقول: قال المحدّث المجلسي في مرآة العقول :
ويظهر من هذا الخبر أنّ محمّد بن يحيى كان في نفسه شيءٌ على البرقي ، والصفّار أثبت له حيرة، وظاهره التحيّر في المذهب، ويمكن أن يكون المراد بَهْته وخرافته في آخر عمره ، أو تحيّره فى الأرض بعد إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى إيّاه من قمّ . وقيل : معناه قبل الغيبة أو قبل وفاة العسكري عليه السلام . وقيل: نقل هذا الكلام من محمّد بن يحيى وقع بعد إبعاده من قمّ وقبل إعادته ، وهو زمان حيرة البرقي بزعم جمع ، أو زمان تردّده في مواضع خارجة من قمّ حيرانا ؛ وذلك لأنّه كان حينئذٍ متّهماً بما قُذف به ، ولم يظهر بعد كذب ذلك القذف . انتهى . وبالجملة ، لا يقدح مثل ذلك في مثله .(2)
ولا يخفى عليك أنّ الاحتمال الأوّل بعيد لا يليق بالرجل ، وكذا احتمال تحيّره في أمر الإمامة قبل العسكري عليه السلام أو القائم عجّل اللّه تعالى فرجه ؛ لأنّه إن تحقّق فيه ما يشعر بذلك لما ندم أحمد بن محمّد بن عيسى من إخراجه ، حيث إنّه أعاده إلى قمّ واعتذر إليه ، ولا زال كان بصدد إبراء نفسه ممّا قذفه به، حتّى أنّه مشى في جنازته حافياً حاسراً ، وذلك يكشف عن استقامته في العقيدة وكونه جليل القدر عظيم المنزلة عنده.
وأمّا احتمال خرافته في آخر عمره ، بحيث يوجب تشويش الفكر ويسقط كلامه عن الاعتبار فبعيد أيضا ؛ لأنّه لم يتفوّه أحد من الرجاليين بذلك ، وحيث إنّه رجل
ص: 156
معروف كثير الرواية، كان أصحاب الحديث بصدد بيان حاله ومرامه ، ولو كان فيه ذلك لذكروها حتماً .
وأضعف من ذلك ما احتمله صاحب التنقيح من أنّ غرض محمّد بن يحيى لم يكن تمنّي كون الراوي للخبر واحداً آخر غير البرقي حتّى يكون قدحاً فيه، بل غرضه - واللّه العالم - تمنّي أن يكون قد جاء هذا الحديث من غير جهة البرقي أيضاً، يعني بسندٍ ثان وثالث ، بحيث يبلغ حدّ التواتر أو الاستفاضة ليرغم به أنف المنكرين . وغرض محمّد بن الحسن في جوابه - واللّه العالم - أنّ الحديث قد تضمّن ذكر الغيبة ، وقد حُدّثت بها قبل وقوعها ، بما يغني ظهور الإعجاز فيها ، وهو الإعلام بما وقع قبل أن يقع عن الاستفاضة ، وحينئذٍ فيتعيّن أن يكون المراد بالحيرة زمن الغيبة - التي هي رأس كلّ بليّة وحيرة - ومن لاحظ الكتب المصنّفة في الغيبة ظهر له أنّ إطلاق لفظ الحيرة على زمن الغيبة شائع ذائع فى لسان الأخبار والمحدّثين .(1) انتهى .
لأنّ هذا الاحتمال مبنيّ على جواز ذكر اللفظ وإرادة خلاف معناه بدون قرينة، وإلاّ فالعبارة لا تحتمل هذا المعنى ؛ لأنّه يصرّح بأنّه يجب أن يكون الراوي غيره ، وهذا ظاهر في كراهية نقل الخبر من طريق البرقي، وإلاّ إن كان مراده تكثير طريق الرواية، لا يعبّر بهذه العبارة ، بل ينبغي أن يقول : «وددت أنّ هذا الخبر جاء من غير أحمد بن أبي عبد اللّه أيضاً» ، مع أنّ هذه العبارة أيضا لا تكون صريحةً في هذا المعنى .
والحاصل : إنّ هذا الاحتمال ممّا لا يرضى به الذوق السليم بل يأباه . والّذي يحتمل قوياً هو أنّه لمّا زعم أحمد بن محمّد بن عيسى فيه ما يوجب عدم الوثوق إليه من فساد العقيدة والتحيّر في أمر الإمامة ، أو غير ذلك من الأُمور التي خفيت علينا فقذفه به وأبعده من قمّ، صار ذلك شائعاً ذائعا بين الرواة وحملة الحديث ، فكدّر عقائدهم الصافية بالنسبة إليه وحدث في نفوسهم من أمره شيءٌ ، فكانوا يزعمون فيه فساد العقيدة ، فحينئذٍ يمكن أن يكون حديث الصفّار لمحمّد بن يحيى ذلك في هذا
ص: 157
الزمان ، فقال له ما قال ، فأجابه الصفّار بأنّ هذا الحديث سمع منه قبل الحيرة ليطمئنّ خاطره، وهذا موافق للاحتمال السادس الذي ذكره المحدّث المجلسي .
وبالجملة ، لا يمكن رفع إليه عن هذه التوثيقات الصريحة المغيّرة بواسطة الخبر المزبور، مع أنّه لايدلّ على ما يكون قدحاً فيه، ولقد أجاد الوحيد في محكي كلامه حيث قال: «إنّ التوثيق ثابت من العدول ، والقدح غير معلوم بل ولا ظاهر» .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا في شرح هذه العدّة أنّ الرواية من طريقهم صحيحة بعلي بن إبراهيم بن هاشم ، وإن لم يظهر حال باقي أشخاصها، والمروي عنه أيضاً صحيح كما عرفت، فينبغي أن يلاحظ من كان قبل أحمد بن محمّد البرقي.
ص: 158
أشخاصها أربعة، قال السيّد الطباطبائي:
وإنّ عدّة التي عن سهل *** من كان فيه الأمر غير سهل
ابن عقيل وابن عون الأسدي *** كذا علي بعد مع محمّد
قال النجاشي رحمه الله بعد عنوانه بما ذكرنا:
يكنّى أبا الحسن، ثقة عين، له كتاب أخبار القائم، أخبرنا محمّد ، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال: حدّثنا علي بن محمّد، وقُتل علاّن بطريق مكّة ، وكان استأذن الصاحب عليه السلام في الحجّ فخرج : توقّف عنه في هذه السنة، فخالف(1) .
وقال العلاّمة رحمه الله في الخلاصة بعد عنوانه بما ذكرنا:
يُكنّى أبا الحسن، ثقة عين، إلاّ أنّ فيها الكلبي مكان الكليني، ولا يبعد أن يكون من أغلاط الطبع(2) .
وقال في التنقيح بعد ذكر كلام النجاشي والعلاّمة وغيرهما:
ووثّقه في الوجيزة والبلغة وغيرهما ، وهو الذي يروي عنه الكليني بغير واسطة كثيراً، وهو داخل في العدّة ، يروي بتوسّطهم عن سهل بن زياد. وقال غير واحد : إنّه أُستاد الكليني وخاله(3) .
هذا حاله في الوثاقة والاعتبار بشهادة أهل الفنّ ، ولكن في النفس شيءٌ من جهة مخالفته للقائم عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف بإتيانه الحجّ ، وهل هذا يضرّ بعدالته؟ إلاّ أنّ الظاهر أنّ الأمر بالتوقّف أمر إرشادي ليس على وجه إعمال المولوية ، فلا
ص: 159
تضرّ مخالفته بوثاقته، وأيضا يمكن أنّه تخيّل أنّ المانع شيءٌ خاصّ، فلمّا ارتفع ذهب إلى الحجّ، وعلى تقدير كون الأمر مولوياً لا تضرّ مخالفته بها لأنّها معصية صغيرة ، وعلى فرض كونها من الكبائر وعدم ندامته بعده، تسقط روايته عن الصحّة بعد المخالفة ؛ لأنّه قبل ذلك كان عادلاً .
والحاصل ، إنّه لا يمكن رفع إليه بسبب هذه المخالفة التي لها احتمالات لا تضرّ بعدالته، ولا تنافيها عن التوثيقات المصرّحة بها في كلام القوم لها.
الظاهر أنّه هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي ، الساكن في الري ، ولذا يُنسب إليه؛ لأنّه يطلق على الأسدي المذكور أنّه أبي عبد اللّه بشهادة النجاشي في كلامه الآتي، وأنّه لا يكون في طبقة مشايخ الكليني من كان بهذا الاسم غيره على الظاهر ممّن جمع مشايخه، ونقل في التنقيح احتمال الميرزا والتفرشي كون الرجل هو محمّد بن جعفر الأسدي ، وأيضاً نقل جزم المجلسي في مرآة العقول، والمولى صالح بذلك .
وبالجملة ، يحصل للمراجع المتتبّع ظنّ قوي، بل وثوق بأنّ المراد بابن أبي عبد اللّه هو الأسدي المذكور، وأمّا استبعاد بعضهم كونه الأسدي فمنشأه قلّة التأمّل في كلام النجاشي ، فلا نطيل الكلام بذكره، فمن أراد الاطّلاع عليه فليراجع إلى كتاب عين الغزال . فاللازم حينئذٍ بيان حال محمّد بن جعفر الأسدي ، فنقول:
قال النجاشي:
محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي، أبو الحسين الكوفي، ساكن الري ، يقال له محمّد بن أبي عبد اللّه، كان ثقة، صحيح الحديث، إلاّ أنّه روى عن الضعفاء ، وكان يقول بالجبر والتشبيه ، وكان أبوه وجهاً، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، له كتاب الجبر والاستطاعة، أخبرنا أبو العبّاس بن نوح ، قال: حدّثنا الحسن بن حمزة ، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الأسدي بجميع كتبه ، قال: ومات أبو الحسين
ص: 160
محمّد بن جعفر ليلة الخميس لعشرٍ خلون من جمادى الأُولى سنة اثنتي عشرة
وثلاثمئة، وقال ابن نوح: حدّثنا الحسن بن داوود، قال: حدّثنا أحمد بن حمدان القزويني عنه بجميع كتبه(1) .
وقال الشيخ في الفهرست:
محمّد بن جعفر الأسدي ، يُكنّى أبا الحسين، له كتاب الردّ على أهل الاستطاعة ، أخبرنا به جماعة ، عن التلّعُكبري، عن الأسدي . وقد عدّه في محكي رجاله ممّن لم يروِ عنهم، وقال أيضا: كان أحد الأبواب .(2)
وعنونه العلاّمة في الخلاصة بمثل ما عنونه النجاشي ، إلاّ أنّ فيها كلمة «سكن» مكان «ساكن» . ثمّ قال في ترجمته بعين ما قال فيه النجاشي إلى آخر قوله . روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى، إلاّ أنّه فرّع على قوله : «وكان يقول بالجبر والتشبيه»، قوله :
«فأنا في حديثه من المتوقّفين»(3)، فيعلم من ذلك أنّ السبب في توقّفه في حديثه هو هذه العقيدة .
ونقل في التنقيح عن الشيخ أنّه قال فى كتاب الغيبة:
وكان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ، ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل ، منهم أبو الحسين بن محمّد بن جعفر الأسدي رحمه الله . أخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد القمّي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن أبي صالح، قال: سألني بعض الناس في سنة تسعين ومئتين قبض شيءٌ فامتنعت من ذلك، وكتبت أستطلع الرأي ، فأتاني الجواب : بالري محمّد بن جعفر العربي فليدفع إليه ؛ فإنّه من ثقاتنا .(4) ونقل حكايات أُخر تدلّ على جلالة شأنه وعظم قدره ، من شاء فليراجع .(5)
ص: 161
هذا حال الرجل كما ترى أنّه ثقة صحيح الحديث، ولكنّ الذى يوجب التردّد في الحكم بذلك ابتداءً هو ما ذكره النجاشي في حقّه من أنّه يقول بالجبر والتشبيه ، ولهذا توقّف العلاّمة في حديثه، ولكن التأمّل القليل في حاله ترفع هذه الشبهة؛ لأنّ الجبر والتشبيه ليسا بظاهرهما مراداً حتماً ؛ لأنّ الاعتقاد بذلك يستلزم الخروج عن المذهب بل عن الدين ، لا عن العدالة والوثاقة .
فكيف يصرّح النجاشي الذي هو أضبط الجماعة بوثاقته مع أنّه جبري قائل بالتشبيه ؛ لأنّ القول بالجبر بمعنى مجبورية العباد في أفعالهم وأعمالهم، وأنّ كلّ ما يفعلونه هو فعل اللّه ومخلوقه - كما هو معتقد الأشاعرة - من أجلى المميّزات بين الشيعة وأهل السنّة ، وهو الذي يصرّ الأئمّة عليهم السلام على إبطاله بقولهم : لا جبر ولا تفويض ، بل أمرٌ بين الأمرين . ويعبّرون عن معتقديه بمجوسي هذه الأُمّة ، وكذا الاعتقاد بأنّه شبيه بالمخلوقات ضلالة محضة ، وبُعد عن مذهب أهل الحقّ ، فاللازم على هذا تأويل كلامه بما لا ينافي توثيقه ، مضافا إلى أنّه لم يجيء في كلام غيره من العظام أنّه قائل بالجبر والتشبيه .
وكيف يشتبه هذا على الكليني الذي روى عنه كثيراً، بل يقال إنّه أُستاذه مع غاية رعايته ودقّته في ضبط الأحاديث، ولو علم منه ذلك لنبّه عليه حتماً ، مضافاً إلى أنّه أحد الأبواب الذي صرّح القائم عجّل اللّه تعالى فرجه بوثاقته ، كما رأيت في التوقيع الخاصّ، فإن تمّ سنده لا نحتاج إلى شيء بعده .
فالحقّ أنّه ثقة صحيح الحديث ، تُقبل روايته ، فلا وجه لتوقّف العلاّمة في حديثه أصلاً، اللّهمّ إلاّ أن يقال : لم يثبت عنده كون الرجل هو محمّد بن جعفر الأسدي، وهو غريب جدّاً ، كما قال في التنقيح على ما مرّ .(1)
ص: 162
قال في عين الغزال في ترجمة محمّد بن الحسن الصفّار:
هو أحد العدّة عن سهل بن زياد، كما نصّ عليه الكاظمي ، وقد صرّح الكليني رحمه الله بالوصف في بعض رواياته عنه تارةً بواسطة محمّد بن يحيى، وأُخرى بلا واسطة، ومنها يظهر ضعف ما احتمل بعض من أنّ محمّد بن الحسن الذي هو أحد العدّة هو محمّد بن الحسن الوليد - أو ابن الحسن البرناني - فما أدري ماله أعرضَ عمّا هو المشهور وتمسّك بقول المزدر! إنّ هذا إلاّ غرور!(1) .
قال النجاشي:
محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار ، مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد اللّه بن السايب بن مالك بن عامر الأشعري، أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القمّيين، ثقة ، عظيم القدر، راجحاً، قليل السقط في الرواية، له كتب . ثمّ عدّ من كتبه خمسة وثلاثين منها .
ثمّ قال: أخبرنا بكتبه كلّها - ما خلا بصائر الدرجات - أبو الحسين علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري القمّي، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه ، بجميع كتبه وببصائر الدرجات، توفّي محمّد بن الحسن الصفّار بقمّ سنة تسعين ومئتين رحمه الله (2).
قال في التنقيح:
قد عدّ الشيخ رحمه الله الرجل من أصحاب العسكري عليه السلام ، قائلاً : محمّد بن الحسن الصفّار إليه - يعني إلى العسكري عليه السلام - مسائل، يلقّب بمموله .(3)
وقال في الفهرست:
محمّد بن الحسن الصفّار ، قمّي، له كتب ، مثل كتب الحسين بن سعيد ، وزيادة كتاب بصائر الدرجات وغيره، وله مسائل كتب بها إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهماالسلام،
ص: 163
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، إلاّ كتاب بصائر الدرجات، فإنّه لم يروه عنه محمّد بن الحسن بن الوليد، وأخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه، عنه(1) .
وعنونه في الخلاصة في القسم الأوّل ، وقال فيه بمثل ما قاله النجاشي(2). والحقّ أنّ ما عنونه الشيخ متّحد مع ما عنون النجاشي ؛ لأنّهما نسبا إليه كتاب بصائر الدرجات ورويا عنه جميع كتبه بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى ، فلا وجه لما توهّم ابن داوود من افتراق الرجلين، فاختلف كلامه في وصفهما ، فعنونه تارةً بمثل ما عنونه النجاشي ووثّقه، وتارةً بمثل ما عنونه الشيخ ولم يوثّقه . ثمّ إن كان المراد بمحمّد بن الحسن الذي وقع في العدّة هو محمّد بن الحسن الصفّار ، فحاله معلوم، وإن كان المراد به محمّد بن الحسن بن الوليد ، فهو أيضا من الكبار الأجلاّء. فلعلّه ستطلع على ما قاله الرجاليون فيه من التوثيق والتبجيل والتعظيم إن شاء اللّه .
وأمّا إن كان المراد به محمّد بن الحسن البرناني ، فحاله غير معلوم عندنا، وحيث إنّ بعض أفراد العدّة من الثقات ، فلا يهمّنا البحث والفحص في تشخيص الرجل، اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ هذا الاسم وقع في غير العدّة أيضاً ، فمعرفته لازم نافع . فنقول : لعلّ اللّه يسّر لنا تحقيق شخصه وحاله فيما يأتي من الزمان.
قال في عين الغزال:
وهو أحد العدّة عن سهل ، ولم أرَ من تعرّض له من الأصحاب بمدحٍ ولا قدح(3) .
ص: 164
قلت: فحينئذٍ إن وقع الرجل في السند في غير العدّة يوجب انقطاعه ، إن لم تكن في طبقته ثقة روى من طريقه أيضاً، الاّ على رأي من يقول بوثاقة مشايخ الإجازة بدون التوثيق.
وأمّا المرويّ عنه لهذه العدّة، فهو سهل بن زياد الأَدَمي الرازي ، أبو سعيد
قال النجاشي:
سهل بن زياد ، أبو علي الأَدَمي الرازي ، كان ضعيفاً في الحديث ، غير معتمد فيه ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب ، وأخرجه من قمّ إلى الري، وكان يسكنها ، وقد كاتب أبا محمّد العسكري عليه السلام على يد محمّد بن عبد الحميد العطّار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة خمسة وخمسين ومئتين، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين رحمهماالله ، له كتاب التوحيد ، رواه أبو الحسن العبّاس بن أحمد بن الفضل بن محمّد الهاشمي الصالحي ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الأَدَمي ، وله كتاب النوادر، أخبرناه محمّد بن محمّد، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب ، قال: حدّثنا علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، ورواه عنه جماعة(1) .
وقال الشيخ رحمه الله في الفهرست:
سهل بن زياد الرازي أبو سعيد الأَدَمي، ضعيف ، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عنه ، ورواه محمّد بن الحسن بن الوليد عن سعد، والحميري عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عنه(2) .
وقال في التنقيح:
عدّه الشيخ رحمه الله - يعني سهل - في رجاله تارةً من أصحاب الجواد عليه السلام ، قائلاً : سهل بن زياد الأَدَمي ، يُكنّى أبا سعيد ، من أهل الري، وأُخرى من أصحاب الهادي عليه السلام ،
ص: 165
قائلاً: سهل بن زياد الأَدَمي يُكنّى أبا سعيد ثقة رازي ، وثالثةً من أصحاب العسكري عليه السلام ، قائلاً: سهل بن زياد ، يُكنّى أبا سعيد الأَدَمي الرازي .(1)
ثمّ نقل عبارة الفهرست، وقال :
وعن موضع من الاستبصار، أنّ أبا سعيد الأَدَمي ضعيف جدّاً عند نقّاد الأخبار ، وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه من كتاب نوادر الحكمة، وقال أيضاً: قال ابن الغضائري: سهل بن زياد أبو سعيد الأَدَمي ، كان ضعيفاً جدّا، فاسد الرواية والدين، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أخرجه من قمّ وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل ، وذكر فيه أيضا نقلاً عن الكشّي، ما سمع علي بن محمّد القتيبي فضل بن شاذان، من أنّه يقول : هو أحمق، يعني سهل بن زياد، ثمّ نقل رأي عمدة من الفقهاء والرجاليّين في حقّه، من أنّه ضعيف، ثمّ قال: بل هو المشهور بين الفقهاء وأصحاب الحديث وعلماء الرجال .
وقال بعضهم بوثاقته ؛ لقول الشيخ في الرجال أنّه ثقة، وأجابوا عن جميع ما يكون قدحاً فيه، أمّا طعن ابن الغضائري فلا يعبأ به ؛ لأنّه كان كثير الجرح . وأمّا تضعيف الشيخ في الفهرست فمنقوض بتوثيقه في رجاله المتأخّر عنه .
وأمّا تضعيف النجاشي فهو متوجّه إلى حديثه لا إلى نفسه، فلم يضعّف الرجل بل ضعّف حديثه .
وأمّا إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى فهو أيضا غير قادح ؛ لأنّه كان يخرج بعض الرواة لأسباب واهية لا تضرّ بعد التهم .
وأمّا قول ابن شاذان فهو يدلّ على أنّه بليد ، لا أنّه مدخول في دينه وتقواه ، ولعلّ وجه رميه بالغلوّ كثرة نقله الأخبار الدالّة على خلاصة الغلاة(2) .
أقول : سلّمنا صحّة الأجوبة المذكورة ، ولكنّ النفس لا يطمئنّ بوثاقته بمجرّد تصريح الشيخ في موضعٍ من رجاله بأنّه ثقة مع تضعيفه سائر الرجاليين، بل المشهور
ص: 166
بينهم وبين الفقهاء ضعفه ، فلا يكون الركون عليه والحكم بصحّة حديثه بمجرّد ذلك ، فعلى هذا لا يحكم بصحّة الرواية عن العدّة الثالثة ؛ لجهالة المروي عنه بل ضعفه.
تمّ بعون اللّه الملك العلاّم ما أردنا إيراده في هذه الرسالة الموسومة بعدّات الكليني ، بعد بروز الموانع وظهور العوائق عن تتميمه ، ونأمل ونرجوا من اللّه العزيز المتعال أن يوفّقنا لإلحاق أحوال سائر مشايخه العظام، منه نستمدّ وعليه التكلان ، والحمد للّه أوّلاً وآخراً من الآن إلى يوم الدين.
ص: 167
الحمد للّه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه، فأظهر فرائضه وبيّن سنَنَه ، فسعد رجالٌ باتّباعها وشقي آخرون بجحودها وإضاعتها، محمّد المصطفى بشير رحمته ونذير نقمته، عليه صلواته وصلوات ملائكته وصلوات الخلق أجمعين ، وعلى آله الذين هم مصابيح الدجى وأعلام التّقى والعروة الوثقى، سيّما ابن عمّه ووارث علمه إمام المتّقين وقائد الغرّ المحجّلين ، عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين.
أمّا بعد، فإنّي قد كنت أرجو منذ أتممت رسالة العدّة أن أنظر في أحوال مشايخ الكليني وأجمعها في أوراق على نسق العدّة ، ولكن الاشتغال بالتحصيل وبروز بعض الموانع حال بيني وبين مأمولي ، حتّى انتهت الأيّام إلى تعطيلات عرفة وعيد الأضحى فساعدنا المجال، فحصلت لي فرصة ما، فاغتنمتها وشرعت في ضبطها من الكتب المعتبرة وتحقيق ما قاله أصحاب الرجال في حقّهم، من الصحّة والسقم، تذكرة لنا عند الاحتياج على ترتيب حروف التهجّي لسهولة الرجوع ، واللّه الموفّق وعنده حسن المآب.
أبو علي الأشعري القمّي؛ تقدّمت ترجمته في العدّة من أنّه : ثقة ، جليل القدر ، فقيه في أصحابنا ، كثير الحديث .
قد ذكرنا في العدّة أنّه لم يتعرّض الرجاليّون لحاله ، وهو مجهول عندنا.
مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السبيعي الهمداني، هكذا عنونه النجاشي ، فقال:
ص: 168
هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ والحكايات ، تختلف عنه في الحفظ وعظمه، وكان كوفيّا زيديا جاروديا على ذلك حتّى مات، وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إيّاهم وعظم محلّه وثقته وأمانته . له كتب ، منها: 1 - كتاب التاريخ وذكر من روى الحديث، 2 - كتاب السنن، 3 - كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، 4 - كتاب من روى عن الحسن والحسين عليهماالسلام، 5 - كتاب من روى عن علي بن الحسين عليه السلام ، 6 - كتاب من روى عن أبي جعفر عليه السلام ، 7 - كتاب من روى عن زيد بن علي، 8 - كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، 9 - كتاب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم، 10 - كتاب أخبار أبي حنيفة ومسنده، 11 - كتاب الولاية ومن روى غدير خم، 12 - كتاب فضل الكوفة، 13 - كتاب من روى عن علي عليه السلام قسيم النار، 14 - كتاب الطائر، مسند عبد اللّه بن بكر بن أعين حديث الراية، 15 - كتاب الشورى، ذكر النبي صلى الله عليه و آله والصخرة والراهب وطرق ذلك، 16 - كتاب الآداب ، وسمعت أصحابنا يصفون هذا الكتاب، 17 - كتاب طريق تفسير قوله تعالى : «إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ»، طرق حديث النبي صلى الله عليه و آله وسلمأنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، عن سعد بن أبي وقّاص، تسميته من شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام حروبه، 18 - كتاب الشيعة من أصحاب الحديث، 19 - كتاب صلح الحسن ومعاوية .
هذه الكتب التي ذكرها أصحابنا وغيرهم ممّن حدّثنا عنه، ورأيت له كتاب تفسير القرآن وهو كتاب حسن كبير ، وما رأيت أحداً ممّن حدّثنا عنه ذكره ، وقد لقيت جماعة ممّن لقيه وسمع منه وأجازه منهم من أصحابنا ومن العامّة ومن الزيدية، ومات العبّاس بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة .(1)
وعنونه الشيخ رحمه الله في محكي الفهرست بمثل ما عنونه النجاشي ، إلاّ أنّ فيه : «عبيد اللّه مصغّراً» مكان «عبد اللّه مكبّرا»، ولعلّه من أغلاط النسّاخ . وزاد بعد ذكر نسبه :
«المعروف بابن عقدة الحافظ» ، فقال :
ص: 169
أخبرنا بنسبه أحمد بن عبدون ، عن محمّد بن أحمد بن الجنيد . وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر ، وكان زيدياً جارودياً وعلى ذلك مات .
وإنّما ذكرناه في جملة أصحابنا ؛ لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم ، وله كتب كثيرة، ثمّ عدّها بمثل ما في النجاشي ، إلاّ أنّه زاد له كتاب من روى عن فاطمة عليهاالسلام من أولادها ، وكتاب يحيى بن حسين بن زيد وأخباره ، ولكنّه لم يذكر كتاب تفسير القرآن وكتاب صلح الحسن ومعاوية . ثمّ قال : أخبرنا بجميع رواياته وكتبه أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي ، وكان معه خطّ أبي العبّاس - يعنى ابن عقدة - بإجازته وشرح رواياته وكتبه عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد، ومات أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد هذا بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة(1) .
وقال الخطيب في تاريخ بغداد:
أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن زياد بن عبد اللّه بن عجلان ، أبو العبّاس الكوفي المعروف بابن عقدة. ثمّ ذكر قدومه بغداد أوّلاً وسماعه من المشايخ ، مثل محمّد بن عبد اللّه المناوي ، وقدومه ثانياً في آخر عمره وحديثه عن هؤلاء وعن غيرهم وذكر أسمائهم فيه . إلى أن قال : وكان حافظا عالماً مكثرا ، جمع التراجم والآداب والمشيخة ، وأكثر الرواية وانتشر حديثه، وروى عنه الحفّاظ والأكابر ، مثل أبي بكر الجعابي .
وذكر أسماء عدّة أُخر ، إلى أن قال بعد صفحة ونصف: أخبرني محمّد بن علي المقرئي، أخبرنا محمّد بن عبد اللّه أحمد النيسابوري ، قال: سمعت أبا علي الحافظ يقول: ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الكوفيّين من أبي العبّاس بن عقدة، حدّثني محمّد بن علي الصوري بلفظه ، قال : سمعت عبد الغني بن سعيد الحافظ يقول: سمعت أبا الفضل الوزير يقول: سمعت علي بن عمر، وهو الدارقطني يقول: أجمع أهل الكوفة أنّه لم يُرَ من زمن عبد اللّه بن مسعود إلى زمن أبي العبّاس ابن عقدة أحفظ منه .
ص: 170
ثمّ أطال الكلام في قوّة حفظه للحديث ودقّته ، ونقل في ذلك حكايات ، وذكر ما جرى بينه وبين ابن صاعد ببغداد ، إلى أن قال : أخبرني محمّد بن علي المقرئي ، حدّثنا محمّد بن عبد اللّه أبو عبد اللّه النيسابوري ، قال: قلت لأبي علي الحافظ: إنّ
بعض الناس يقولون في أبي العبّاس ، قال: في ماذا ؟ قلت: في تفرّده بهذه المقحمات عن هؤلاء المجهولين ، فقال: لا تشتغل بمثل هذا، أبو العبّاس إمام حافظ ، محلّه محلّ من يسأل عن التابعين وأتباعهم .(1)
ثمّ نقل عن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل يقول:
منذ نشأ هذا الغلام أفسد حديث الكوفة، يعني أبا العبّاس بن عقدة، ثمّ قال: حدّثني محمّد بن علي الصوري قال: قال لي أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي ، قال لنا أبو الحسن علي بن محمّد التمّار، قال لنا أبو العبّاس ابن سعيد: كان قد أتى كتاب فيه نحو خمسمئة حديث ، عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي ، لا أعرف له طريقاً .
قال أبو الحسن: فلمّا كان يوم من الأيّام قال لبعض ورّاقيه: قمّ بنا إلى بجيلة موضع المغنّيات، فقلت: إيش نعمل؟ فقال: بلى تعال، فإنّها فائدة لك ، قال: فامتنعت عليه، فغلبني على المجيء . قال: فجئنا جميعاً إلى الموضع، فقال لي : سل عن قصيعة المخنّث، قال : فقلت: اللّه اللّه يا سيّدي أبا العبّاس ، ذا فضيحة لا تفضحنا! قال: فحملني الغيظ فدخلت ، فسألت عن قصيعة ، فخرج إليّ رجل في عنقه طبل مخضّبٌ بالحناء ، فجئت به إليه فقلت: هذا قصيعة، فقال: يا هذا ، امض فاطرح عليك والبس . وعاد فمضى ولبس قميصه وعاد ، فقال له : ما اسمك؟ فقال: قصيعة ، قال: دع هذا عنك ؛ هذا شيءٌ لقّبك به هؤلاء، ما اسمك على الحقيقة؟ قال: محمّد ، قال: صدقت، ابن من؟ قال: ابن علي، قال: صدقت، ابن من؟ قال: حمزة، قال: صدقت، ابن من؟ قال: لا أدري واللّه يا أُستاذي! قال: أنت محمّد بن علي بن حمزة بن فلان بن فلان بن حبيب بن أبي ثابت الأسدي . قال: فأخرج من كُمّه الجزء فدفعه إليه ، فقال له : امسك هذا، فأخذه ثمّ قال : ادفعه إليَّ، ثمّ قال لي: قمّ انصرف، ثمّ جعل أبو
العبّاس يقول، دفع إليَّ فلان بن فلان بن فلان بن حبيب بن أبي ثابت كتاب جدّه ،
ص: 171
فكان فيه كذا وكذا .
فقال الخطيب: قلت: وسمعت من يذكر أنّ الحفّاظ كانوا اذا أخذوا في المذاكرة شرطوا أن يعدلوا عن حديث أبي العبّاس بن عقدة لاتساعد ، وكونه ممّا لا ينضبط .
ثمّ ذكر ما يكون طعنا فيه ، إلى أن نقل عن أبي بكر بن أبي غالب أنّه يقول : ابن عقدة لا يتديّن بالحديث ؛ لأنّه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب ، يسوّي لهم نسخة ويأمرهم أن يردّوها ، كيف يتديّن بالحديث ويعلم أنّ هذه النسخ هو دفعها إليهم ثمّ يرويها عنهم، وقد بيّنا ذلك منه غير شيخ بالكوفة .
ثمّ ذكر بطرق عديدة ما يدلّ على عدم مبالاته في جمع الحديث . ثمّ قال : حدّثني أبو عبد اللّه أحمد بن أحمد بن محمّد القصري ، قال: سمعت أبا الحسن محمّد بن أحمد بن سفيان الحافظ يقول: وُجّهَ إلى أبي العبّاس بن عقدة من خراسان بمال وأمر أن يعطيه إلى بعض الضعفاء ، وكان على باب جاره صخرة عظيمة، فقال لابنه: ارفع هذه الصخرة ، فلم يستطع رفعها ؛ لعظمها وثقلها ، فقال له: أراك ضعيفاً ، فخذ هذا المال وادفعه إليه ... وقال بعد ذلك : حدّثنا أبو طاهر حمزة بن محمّد بن طاهر الدقّاق ، قال: سُئل أبو الحسن الدارقطني - وأنا أسمع - عن أبي العبّاس بن عقدة ، فقال: رجل سوء ... ونقل عن أبي الحسن بن سفيان الحافظ أنّ وفاته سنة اثنين وثلاثين وثلاثمئة . وذكر أنّه ولد ليلة النصف من المحرّم سنة تسعة وأربعين ومئتين .(1)
وعنونه العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصة بمثل ما عنونه النجاشي زائداً بعد الهمداني:
الكوفي المعروف بابن عقدة ، يُكنّى أبا العبّاس، جليل القدر، عظيم المنزلة ، وكان زيدياً جارودياً وعلى ذلك مات . ثمّ قال: قال الشيخ رحمه الله : سمعت جماعة يحكون عنه أنّه قال: أحفظُ مئة وعشرين ألف حديثاً بأسانيدها وأُذاكر ثلاثمئة ألف حديث(2) .
ص: 172
والظاهر من عدّه في القسم الثاني أنّه تارك لحديث أبي العبّاس ، أو متوقّف في قبوله لما قاله في أوّل الكتاب ، واعترض عليه صاحب التنقيح بأنّه لا معنى لعدّه في القسم الثاني بعد توثيقهم له ، ونقل اعتراض صاحب النقد عليه أيضا ، بأنّ الأولى توثيقه وعدّه في القسم الأوّل كما ذكر فيه من هو أدنى منه كثيراً، مثل محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي ومحمّد بن عبد الرحمن السهمي وغيرهم، مع أنّ المدح الذي نقل في شأن هذين منقول عن ابن عقدة . ثمّ نقل عنه أنّه قال : وكذا فعل ابن داوود . انتهى المنقول من النقد .(1)
فوجّه اعتراضه عليه وزاد بأنّه قد عدّ في القسم الأوّل جماعة كان مذهبهم على خلاف الحقّ ، كالفطحية بمحض شهادة أصحابنا بأنّهم ثقات ، فعدّه له في القسم الأوّل كان أولى .
أقول : اعتراضهما غير وارد عليه ، نشأ من عدم التتبّع ، إذ لعلّه اطّلع على ما نقله الخطيب وغيره ممّا يدلّ على عدم مبالاته في حفظ الحديث وتدليسه في جعل الطريق وغيره ممّا يضرّ بعدالته ، فأوجب ذلك أن لا يعمل بتوثيق الشيخ والنجاشي له ، ويترك حديثه ؛ لكونه مجروحاً مطعوناً ، والجرح مقدّم على التعديل ، وإن كان المعدّل متعدّداً والجارح واحداً ، سيّما إذا كان سبب الجرح معلوماً.
قال الشهيد الثاني في الدراية:
ولو اجتمع في واحد جرح وتعديل ، فالجرح مقدّم على التعديل ، وإن تعدّد المعدّل وزاد على عدد الجارح على القول الأصحّ؛ لأنّ المعدّل مخبر عمّا ظهر عن حاله، والجارح يشتمل على زيادة الاطّلاع ؛ لأنّه يخبر عن باطن خفي على المعدّل ، فإنّه لا يعتبر فيه ملازمته في جميع الأحوال ، فلعلّه ارتكب الموجب للجرح في بعض الأحوال التي فارقه فيها، هذا إذا أمكن الجمع بين الجرح والتعديل ... إلخ .(2)
ص: 173
نَعَم ، لمّا كان المعدّل إمامي ثقة ، والجارح غير إمامي مجهول الحال (مجهول عندي) لا يمكن الحكم بفسقه وضعفه وتقديم قول الجارح ، ولكن يوجب ذلك سلب الاطمئنان عنه وعدم قبول روايته ، ولعلّ العلاّمة أيضاً من المتوقّفين في حديثه لذلك .
والحاصل ، إنّ الحقّ مع العلاّمة ابن داوود ، واعتراض هذين غير وارد ؛ إذ الأقوال فيه مختلفة لا يمكن الركون إلى أحد الطرفين لما ذكرنا، فالرجل مجهول الحال إن لم نقل بأنّه ضعيف ؛ لما يؤيّد قول الجارحين من أن الإكثار في الرواية يستلزم طبعاً عدم المراعاة والدقّة في ضبطها.
وأمّا اعتراض صاحب النقد على العلاّمة بأنّه نقل المدح في شأن الرجلين عن ابن عقدة ، ففيه : إنّه قدس سره صرّح بأنّه لا يريد بما رواه في مدحهما تعديلاً للرجلين، مع أنّه متضمّن للتوثيق بل جعله من المرجّحات ، وهذا دليل على عدم وثوقه به وأنّه لا يكون عنده من الثقات ، وإلاّ فلا معنى لعدم قبول ما نقله من التوثيق ، فتأمّل . وأمّا ما ذكره صاحب التنقيح بأنّه ذكر في القسم الأوّل من كان مذهبه على خلاف الحقّ بمجرّد توثيق الأصحاب، ففيه : إنّ التوثيق فيهم غير معارض بالجرح ، بخلاف ما نحن فيه، ولا إشكال في قبول رواية الغير الإمامي إذا كان موثّقاً؛ لأنّ الملاك في قبول الخبر هو الاطمئنان والوثوق بصدوره عن المعصوم ، سواء كان الحديث صحيحاً أو موثّقاً .
وهو ابن أخي أبي الحسن علي بن عاصم المحدّث ، يقال له : العاصمي .
هكذا عنونه النجاشي فقال:
كان ثقة في الحديث سالماً خيّرا، أصله كوفي وسكن بغداد، روى عن الشيوخ الكوفيّين، له كتب ، منها : كتاب النجوم وكتاب مواليد الأئمّة وأعمارهم ، أخبرنا أحمد بن علي بن نوح ، قال : حدّثنا الحسين بن علي سفيان عن العاصمي(1) .
ص: 174
وذكره الشيخ في محكي الفهرست هكذا، إلاّ أنّه أسقط ما بين محمّد وعاصم ، وقال :
ثقة في الحديث سالم الجنبة، أصله الكوفة سكن ببغداد، روى عن شيوخ الكوفيّين ، وله كتب ، منها: كتاب النجوم ، أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان وأحمد بن عبدون ، عن محمّد بن أحمد بن الجنيد أبي علي، قال : حدّثنا العاصمي(1).
وذكره العلاّمة في القسم الأوّل ، إلاّ أنّه أسقط اسم جدّه الأدنى أحمد، ووثّقه بمثل ما ذكره الشيخ إلى قوله : وله كتب ، إلاّ أنّه قال :
روى عن جميع شيوخ الكوفيّين، فهو بعدما سمعت من التوثيق في حقّه إمامي ثقة(2) .
أضف إلى ذلك ما في عين الغزال حيث قال :
قال العلاّمة المجلسي والمحقّق البحراني بعد ترجمته : إنّه أُستاذ الكليني .
وفي منتهى المقال :
إنّ العاصمي من الوكلاء الذين رأووا الصاحب ووقفوا على معجزته .
وقال في خاتمة رجال الكبير عند ذكر وكلائه :
قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله : حدّثنا محمّد بن محمّد الخزاعي عن أبي علي الأسدي ، عن أبيه محمّد بن عبد اللّه الكوفي ، أنّه ذكر عدد من انتهى إليه ممّن وقف على معجزات صاحب الزمان (عج)، ورآه من الوكلاء ببغداد العمري وابنه وحاجز والبلالي والعطاء ، ومن الكوفة العاصمي(3) .
لم يذكره النجاشي ، ولكن عنونه العلاّمة في القسم الثاني من الخلاصة ، حيث قال:
أحمد بن مهران، روى عنه في كتاب الكافي، قال ابن الغضائري: إنّه ضعيف .(4)
ص: 175
ونقل في التنقيح مناقشة المحقّق الوحيد رحمه الله في التعليقة بأنّ الكليني رحمه الله ترحّم عليه في الكافي في باب مولد الكاظم عليه السلام ، وفي باب مولد الزهراء عليهاالسلام ، وفي باب نكت التنزيل في الولاية مكرّراً ، وغير ذلك من المواضع ، وهو يكثر من الرواية عنه، وهو عن عبد العظيم الحسني الجليل النبيل، وخالي رحمه الله وصفه بأُستاذ الكليني رحمه الله وضعّفه، وفي التضعيف ضعف ؛ لكونه من ابن الغضائري مع مصادمته لما ذكر ، فتأمّل . انتهى(1).
أقول: إكثار الرواية عنه والترحّم عليه من الكليني وكونه أُستاذه ، لا توجب التوثيق مع معارضته التضعيف المزبور ، وعدّه العلاّمة في قسم الضعفاء وتضعيف المجلسي ، والأصل أنّ الرجل لا يُركن إليه ، ولعلّ وجه التأمّل في كلام الوحيد ذلك.
قال في التنقيح:
قال الشيخ رحمه الله في محكي كتاب الغيبة: أخبرني جماعة عن جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراري ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، قال: سألت محمّد بن عثمان العمري - رضي اللّه عنه - ، أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه مسائل أشكلت عليَّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الدار عليه السلام : أمّا ما سألت عنه - أرشدك اللّه تعالى وثبّتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا، فاعلم إنّه ليس بين اللّه عزّ وجلّ وبين أحد قرابة ، ومن أنكرني فليس منّي وسبيله سبيل ابن نوح، وأمّا سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السلام . إلى أن كتب عليه السلام : وأمّا وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبتها عن الأبصار السحاب ، وإنّي لأمان لأهل الأرض كما أنّ النّجوم أمان لأهل السماء ، فأغلقوا باب السؤال عمّا لا يعنيكم ، ولا تتكلّفوا علم ما قد كُفيتم ، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ؛
فإنّ ذاك فرجكم، والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتّبع الهدى .
قال بعد ذلك : ويُستفاد من توقيعه عليه السلام هذا جلالة الرجل وعلوّ رتبته، وكونه هو
ص: 176
الراوي غير ضائر بعد تسالم المشايخ على نقله(1) .
أقول: لا يمكن إثبات الوثاقة بشهادة الإنسان لنفسه أو نقله ما يدلّ على ذلك ، ما لم يسبقها معاشرة كاشفة عن صلاحه أو شهادة عدل آخر مطّلع مع حاله أقلاًّ، إلاّ أن يحصل الاطمئنان من قوله ابتداءً ، وهو كما ترى ، فلا يجوز إثبات وثاقة الرجل بالتوقيع المزبور المروي من طريقه، ونقله المشايخ أعمّ من ذلك .
روى عنه الكليني في باب حدّ النباش من أبواب الحدود ، وهو غير مذكور في كتب الرجال أصلاً على ما في عين الغزال .
قال في عين الغزال : «روى عنه حديثاً في باب مولد الصاحب» ، ويظهر منه أنّ أباه من وكلائه عليه السلام ، وهما غير مذكورين في كتب الرجال.
لم يتعرّض علماء الرجال لحاله على ما قاله صاحب التنقيح في رجاله ، ولكن نقل الكليني رحمه الله في باب مولد الصاحب روحي وروح العالمين له الفداء عنه ما يدلّ على أنّه رأى القائم عجّل اللّه تعالى فرجه، وقوفه على معجزته ، حيث قال:
الحسن بن الفضل بن زيد اليماني، قال: كتب أبي بخطّه كتاباً فورد جوابه ، ثمّ كتبت بخطّي فورد جوابه ، ثمّ كتب بخطّه رجل من فقهاء أصحابنا فلم يرد جوابه ، فنظرنا فكانت العلّة أنّ الرجل تحوّل قرمطيّاً،(2) قال الحسن بن الفضل: فزرت العراق
ص: 177
ووردت طوس وعزمت أن لا أخرج إلاّ عن بيّنة من أمري ونجاح من حوائجي ، ولو احتجت أن أُقيم بها حتّى أتصدّق ، قال: وفي خلال ذلك يضيق صدري بالمقام وأخاف أن يفوتني الحجّ، قال: فجئت يوماً إلى محمّد بن أحمد أتقاضاه، فقال لي: صر إلى مسجد كذا وكذا ، وأنّه يلقاك رجلٌ. قال: فصرت إليه فدخل عليّ رجلٌ ، فلمّا نظر إليَّ ضحك وقال : لا تغتمّ ؛ فإنّك ستحجّ في هذه السنة وتنصرف إلى أهلك وولدك سالماً، قال: فاطمأننت وسكن قلبي وأقول: ذا مصداق ذلك والحمد للّه .
قال: ثمّ وردت العسكر فخرجت إليَّ صرّة فيها دنانير وثوب، فاغتممت وقلت في نفسي: جزائي عند القوم هذا ، واستعملت الجهل، فرددتها وكتبت رقعة ولم يشر الذي قبضها منّي عليَّ بشيء ولم يتكلّم فيها بحرف، ثمّ ندمت بعد ذلك ندامة شديدة وقلت في نفسي: كفرت بردّي على مولاي وكتبت رقعة أعتذر من فعلي وأبوء بالإثم وأستغفر من ذلك ، وأنفذتها وقمت أتمسّح، أي لا شيء معي، فأنا في ذلك أُفكّر في نفسي وأقول: إن ردّت عليَّ الدنانير لم أحلل صرارها ولم أُحدث فيها حتّى أحملها إلى أبي ؛ فإنّه أعلم منّي ليعمل فيها بما شاء . فخرج إليَّ الرسول الذي حمل إليَّ الصرّة ، فقال لي: أسأت إذ لم تعلم الرجل إنّا ربّما فعلنا ذلك بموالينا ، وربّما سألونا ذلك يتبرّكون به . وخرج إليَّ : أخطأت في ردّك برّنا فاستغفرت اللّه، فاللّه يغفر لك ، فأمّا إذا كانت عزيمتك وعقد نيّتك ألاّ تحدث فيها حدثاً ولا تنفقها في طريقك، فقد صرفناها عنك ، فأمّا الثوب فلابدّ منه لتحرم فيه .
قال: وكتبت في معنيين ، وأردت أن أكتب في الثالث وامتنعت منه ؛ مخافة أن يكره ذلك ، فورد جواب المعنيين والثالث الذي طويت مفسّرا والحمد للّه .
قال: وكنت وافقت جعفر بن إبراهيم النيسابوري بنيسابور على أن أركب معه وأُزامله ، فلمّا وافيت بغداد بدا لي فاستقلته ، وذهبت أطلب عديلاً، فلقيني ابن الوجناء بعد أن كنت صرت إليه أن يكتري لي، فوجدتة كارهاً، فقال لي : أنا في طلبك ، وقد قيل لي إنّه يصحبك ، فأحسن معاشرته واطلب له عديلاً واكتر له .(1)
ص: 178
أقول: هذه الحكاية تدلّ على جلالة قدره وخلوصه في التشيّع ، حتّى نال هذه المرتبة وصار مورداً لعناية الإمام عليه السلام ، ولكن لمّا كان الراوي شخصه ، فلا يمكن إثبات وثاقته بهذه الحكاية ، فيكون مجهول الحال.
قال في عين الغزال:
لم يذكره أصحاب الرجال في عداد مشايخه ، وروى عنه في بعض المواضع ، منها: في باب الإشارة والنصّ على الحسن بن علي ، وباب مولد أبي الحسن علي بن محمّد التقي ، وباب مولد الصاحب عليهم السلام .
قال الشيخ بسندٍ يأتي في عبد اللّه بن العبّاس العلوي، أنّه قال: دخلت على أبي محمّد عليه السلام بسرّ من رأى ، فهنّيته بسيّدنا صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه لمّا ولد(1).
قال في التنقيح:
روى عنه الكليني في مولد الحجّة عليه السلام ، وفي كتاب المعيشة وكتاب المكاسب بعنوان الحسين بن الحسن الهاشمي .
قال في عين الغزال:
روى عنه في باب مولد الصاحب عجّل اللّه فرجه ولم أرَ ذكراً منه في كتب الرجال»(2) .
عنونه النجاشي بهذا ، فقال:
ثقة ، له كتاب النوادر، أخبرناه محمّد بن محمّد ، عن أبي غالب الزراري ، عن محمّد بن يعقوب عنه .(3)
ص: 179
وقال العلاّمة في القسم الأوّل تحت الرقم 24:
الحسين الأشعري القمّي ، أبو عبد اللّه ، ثقة(1) .
وقال في التنقيح بعد ذكر كلام النجاشي والعلاّمة:
وعن المحققّ الداماد أنّه أحد أجلاّء مشايخ الكليني رحمه الله ، وقد أكثر الرواية عنه في الكافي ، وقد صرّح باسم جدّه عامر الأشعري في مواضع عديدة، ووثّقه المولى صالح المازندراني .(2)
وقال الشيخ البهائي في حواشي الحبل:
إنّ الحسين بن محمّد هو شيخ الكليني ، ثقة ، من أكابر القمّيين الأشعريين .
ووثّقه في الوجيزة ومشتركات الكاظمي وغيرهما أيضاً(3).
الثالث عشر: حميد(4) بن زياد بن حمّاد بن حمّاد بن زياد هَوَاز الدهقان أبو القاسم
عنونه النجاشي بهذا ، فقال:
كوفي ، سكن سوراء وانتقل إلى نينوى، قرية على العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السلام، كان ثقة ، واقفاً ، وجهاً فيهم، سمع الكتب وصنّف كتاب الجامع في أنواع الشرائع - إلى أن قال - : ومات حميد سنة عشر وثلاثمئة(5) .
وعدّه الشيخ في محكي رجاله ممّن لم يروِ عنهم عليهم السلام قائلاً :
حميد بن زياد ، من أهل نينوى ؛ قرية بجنب الحائر على ساكنه السلام ، عالم جليل ، واسع العلم ، كثير التصانيف ، قد ذكرنا طرفاً من كتبه في الفهرست .(6)
ص: 180
وقال في محكي الفهرست بعد ذكر اسمه ومحلّه:
ثقة ، كثير التصانيف ، روى الأُصول أكثرها، له كتب كثيرة على عدد كتب الأُصول(1).
قال في التنقيح:
إنّ بين كلام الشيخ والنجاشي تنافياً ؛ لأنّ إطلاق الشيخ يدلّ على كونه إمامياً ، ولكن قال النجاشي : إنّه واقفي(2) .
وذكره العلاّمة في القسم الأوّل من رجاله ، فقال بعد نقل كلام الشيخ والنجاشي في ترجمته:
فالوجه عندي قبول روايته إذا خلت عن المعارض(3) .
أقول: حديثه ليس بصحيح وإن كان ثقة ؛ لأنّه ليس إمامياً ، فيلحق بالموثّق فيقبل قوله ما لم يعارضه قول إمامي ثقة، فالوجه ما ذكره العلاّمة ، وأمّا الذين رووا عنه ففي
محكي المشتركات :
ابن زياد الثقة ، الواقفي ، عنه أبو طالب الأنباري وأبوالمفضّل الشيباني وأحمد بن جعفر بن سفيان والكليني .
تقدّم ذكره في العدّة الأُولى، وأنّ الأقوى التوقّف في حديثه.
قال النجاشي بعد عنوانه بهذا زائدا :
القمّي ، أبو القاسم، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً ، وسافر في طلب الحديث ، لقي من وجوههم الحسن بن عرفة ، ومحمّد بن عبد الملك الدقيقي ، وأبا حاتم الرازي وعبّاس الترقفي(4) ، ولقي مولانا
ص: 181
أبا محمّد عليه السلام ، ورأيت بعض أصحابنا يضعّفون لقاءه لأبي محمّد عليه السلام ، ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه ، واللّه أعلم، وكان أبوه عبد اللّه بن أبي خلف قليل الحديث، روى عن الحكم بن مسكين ، وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وصنّف سعد كتباً كثيرة، وقع إلينا منها كتاب الرحمة .
ثمّ سرد كتبه ممّا وصل إليه - إلى أن قال - : أخبرنا محمّد بن محمّد والحسين بن عبيد اللّه والحسين بن موسى ، قالوا: حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال: حدّثنا أبي وأخي ، قالا: حدّثنا سعد بكتبه كلّها ، قال الحسين بن عبيد اللّه رحمه الله : جئت بالمنتخبات (من كتب سعد) إلى أبي القاسم بن قولويه رحمه الله أقرأها عليه ، فقلت: حدّثك سعد؟ فقال : لا، بل حدّثني أبي وأخي عنه ، وأنا لم أسمع من سعد إلاّ حديثين . توفّي سعد رحمه الله سنة إحدى وثلاثمئة وقيل : سنة تسع وتسعين ومئتين .(1)
وفي التنقيح: قال الشيخ في رجاله في أصحاب العسكري عليه السلام :
سعد بن عبد اللّه القمّي عاصره - يعني العسكري - ولم أعلم أنّه روى عنه .(2)
وقال في باب من لم يروِ عنهم عليهم السلام:
سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف القمّي ، جليل القدر ، صاحب تصانيف ، ذكرناها في الفهرست، روى عنه ابن الوليد وغيره ، روى ابن قولويه عن أبيه عنه .(3)
وقال في الفهرست:
سعد بن عبد اللّه القمّي ، يُكنّى أبا القاسم، جليل القدر ، واسع الأخبار ، كثير التصانيف ، ثقة. ثمّ عدّ بعض كتبه(4) .
وذكر فيه أيضاً توثيق جمله من الرجاليين إيّاه ، ثمّ قال:
بل ادّعى ابن طاووس فى الإقبال الاتّفاق عليه ، حيث قال: أخبرنا جماعة بإسنادهم إلى سعد بن عبد اللّه من كتاب فضل الدعاء، المتّفق على ثقته وفضله
ص: 182
وعدالته .(1)
وقال العلاّمة في القسم الأوّل :
سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الأشعري القمّي، يُكنّى أبا القاسم، جليل القدر ، واسع الأخبار ، كثير التصانيف ، ثقة، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها ، ولقي مولانا أبا محمّد العسكري عليه السلام . ثمّ نقل ما ذكره النجاشي من تضعيف بعض الأصحاب لقاءه لأبي محمّد عليه السلام ، ونقل عنه أيضا القولين في سنة وفاته . فقال : وقيل: مات رحمه الله يوم
الأربعاء لسبع وعشرين من شوّال سنة ثلاثمئة في ولاية رستم .(2)
ونقل في التنقيح :
إنّ ابن داوود ذكره في القسم الأوّل من كتابه ، ونقل خلاصة كلام النجاشي، ثمّ عدّه في القسم الثاني المعدّ للضعفاء الذين لا اعتماد عليهم ؛ لكونهم مجروحين أو مجهولين، ونسب إلى الكشّي كونه من أصحاب العسكري عليه السلام . ثمّ نقل عن النجاشي تضعيف بعض الأصحاب لقاءه أبا محمّد ، ويقول : هذه حكاية موضوعة ، فاستغرب عن كلام ابن داوود غاية الاستغراب مع كون الرجل ممّن لا خلاف ولا ريب بين أرباب الفنّ وثاقته وعدالته ، وهو كذلك .
ثمّ قال: إن كان سبب عدّ الرجل في الضعفاء تضعيف بعض الأصحاب لقاءه العسكري عليه السلام فأغرب، ضرورة عدم اللقاء ، مع أنّهما في بلدين متباعدين، لا يوجب قدحاً ، ثمّ استحسن ما علّقه الشهيد الثاني على كلام ابن داوود بما يقرب ممّا قاله(3) .
والحاصل ، إنّ الرجل موثّق بشهادة المعتمدين من أصحاب الفنّ ، فلا يُلتفت إلى خلافه ما لم يعضده دليل.
ينبغي أن نتكلّم في ترجمة الرجل في جهاتٍ ثلاثة :
ص: 183
الجهة الاُولى: إنّ أبا داوود الذي روى عنه الكليني بلا واسطة تارةً مثلما رواه في الفروع في باب الحبلى ترى الدم ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داوود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد . وفي باب النفساء أيضا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داوود ، عن الحسين بن سعيد ، وغير ذلك ممّا يعثر عليه المتتبّع، هل هو سليمان بن سفيان المسترقّ المكنّى بأبي داوود الذي روى عنه في بعض الموارد بواسطة، وفي بعضٍ بواسطتين مصرّحاً بلقبه تارةً، وتاركاً أُخرى؟ مثلما رواه في باب طهور الماء ، الحديث الثالث (هذا الباب أوّل أبواب الطهارة): محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي داوود المنشد ، عن جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وما رواه في باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء وللغسل ، هكذا: عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داوود ، جميعاً عن الحسين بن سعيد . وما رواه في الباب 139 كراهية الرهبانية وترك الباه من أبواب النكاح ، الحديث الرابع : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبي داوود المسترقّ ، عن بعض رجاله ، فيه قولان :
الأوّل : ما نقله المامقاني في فصل الكُنى في آخر رجاله عن الميرزا رحمه الله ، حيث قال:
روى محمّد بن يعقوب ، عن أبي داوود ، عن الحسين بن سعيد ، وليس بالمسترقّ ،
وإلى الآن لم يتبيّن لي من هو ، فتدبّر .(1)
وفي هامش نسخة مصحّحة من المنهج زيادة قوله، إذ ليس بالمسترقّ قطعاً ؛ لأنّه لا يحتمله تاريخه ، ولم أجد من أصحابنا من يحتمله، نعم يحتمله أبو داوود، سليمان بن أشعث السِّجِستاني ، فإنّه ولد سنة اثنتين ومئتين وبقي إلى شوّال سنة خمس وسبعين ومئتين، وهو من أكابر أئمّة الحديث منهم . انتهى .
الثاني : القول بأنّهما واحد، وهو المنقول عن السيّد الداماد والعلاّمة المجلسي
ص: 184
على ما نقله صاحب التنقيح عن الوحيد ، حيث قال في ذلك الباب بعدما نقله عن الميرزا:
ولكنّ المولى الوحيد رحمه الله نقل عن السيّد الداماد القطع بكون أبي داوود في طريق الكليني هو المسترقّ، ونقل عن جدّه المجلسي استظهار ذلك ، وأنّه قال: كان له كتاب يروي الكليني عن كتابه ، ويروي عنه بواسطة الصفّار وغيره، ويروي أيضا بواسطتين عنه ، ولمّا كان الكتاب معلوماً عنده يقول: روى أبو داوود ، فالحديث ليس بمرسل . انتهى (يعنى كلام جدّه) .
وقال في موضعٍ آخر - يعني جدّه - :
اعلم إنّه كثيرا ما يروي الكليني رحمه الله عن أبي داوود المنشد أو المسترقّ ، ويظهر منه أنّه رآه، والظاهر أنّه لم يره ، وقال أيضا : واعلم إنّه كثيرا ما يروي الكليني عن أبي داوود ، عن الحسين بن سعيد، والمسموع من المشايخ أنّه المسترقّ .
ثمّ قال الوحيد رحمه الله :
ويؤيّد ما ذكرا رواية الكليني بواسطة العدّة عنه مع مشاركة أحمد بن محمّد في بعض المواضع، منها ما رواه في باب ما يستحبّ للنفساء هكذا: محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داوود ، عن الحسين بن سعيد ؛ لأنّ طبقة أحمد طبقة المسترقّ ، وأحمد لقي الرضا عليه السلام والجواد عليه السلام والعسكري عليه السلام وابتداء إمامة العسكري عليه السلام بعد عشرين ومئتين ، والمسترقّ توفّي سنة إحدى وثلاثين ومئتين ، وعاش سبعين سنة، فتولّد سنة تسع وخمسين ومئة ، وهو زمان الكاظم عليه السلام . ورواية الكليني عنه في بعض المواضع بلا واسطة، الظاهر أنّها باب التعليق كما هو دَيْدَنُه إلى كثير من الروايات فتأمّل .(1)
انتهى كلام الوحيد رحمه الله وعليك بالتدبّر فيه . انتهى المنقول عن التنقيح .
أقول: إدراك الكليني زمان أبي داوود المسترقّ وسماعه منه الحديث ، في غاية البعد والغرابة ، إلاّ أن يقال إنّه عاش مئة وعشرين سنة، فيكون سنّه حين وفاة
ص: 185
المسترقّ اثنتان وعشرون ، وهذا أغرب منه ؛ لأنّه وإن لم ترَ من تعرّض لمدّة حياته ، بل اقتصروا على ذكر سنة وفاته ، ولكن إن عُمِّرَ رحمه الله هذا المقدار لصار ذائعا شائعاً وليس ممّا يخفى على أصحاب الرجال .
لابدّ من الالتزام بأحد هذين على سبيل منع الخلوّ، إمّا القول بأنّ أبا داوود الذي روى عنه بلا واسطة غير المسترقّ، أو أنّه هو المسترقّ ، ولكن روى عن كتابه لوثوقه بالكتاب، قد يقوى في النظر أنّه هو المسترقّ وأنّ الكليني نقل عن كتابه ؛ لما ذكر المجلسي والسيّد الداماد من أنّ طبقته لا يحتمله ، والمسموع من المشايخ اتّحادهما، ولكن التأمّل يؤتي خلافه ؛ لأنّ عدم اتّحاد الطبقة لا يقتضي أكثر من أنّ الذي روى عنه غيرُ المسترقّ ، ولكن اتّحادهما لا يثبت بذلك، وكذا صِرف السماع من المشايخ ما لم يذكر منهم دليل عليه ولم يوجب الاطمئنان والوثوق الشخصي لا يمكن الركون إليه، فلعلّ ما ذكره المشايخ مبنيّة على اجتهاداتهم ، وهي ليست حجّة لنا، مع أنّا لم نجد قرينة تدلّ على ذلك في كتاب الكافي .
إن قلت: إنّه قد صرّح في بعض المواضع بلقبه بقوله : «أبو داوود المسترقّ» ، كما مرّ فاكتفى بذلك عن ذكره في سائر الموارد ، فيكشف عنه أنّه هو .
قلت: إنّ الموارد التي ذكره ملقّبا يكون فيما نقل عنه بواسطتين على ما رأينا، فيكشف عنه أنّه إن وقع الرجل في إسناده وتقدّم عليه بطبقة أو طبقتين عليه، يحكم بأنّه هو المسترقّ، بخلاف ما إذا نقل عنه بلا واسطة فلا دليل عليه، فلا يحكم باتّحادهما . وأمّا ما يظهر ممّا ذكره المجلسي رحمه الله في قوله المتقدّم : «اعلم إنّه كثيرا ما يروي الكليني عن أبي داوود المنشد أو المسترقّ» من أنّ الكليني رحمه الله صرّح بلقب أبي داوود فيما روى عنه بلا واسطة أيضاً، فهو مبنيّ على استنباطه بأنّه هو المنشد ، وإلاّ إن صرّح رحمه الله بذلك كان قرينة قوية على أنّهما واحد وأنّه رحمه الله أخذ من كتابه لاختلاف الطبقة،
فحينئذٍ لا معنى للاختلاف بين الرجاليّين.
والحاصل : إنّ النفس كلّما تريد أن تذهب إلى القول بكونهما متّحدَيْن الدليل، فلم
ص: 186
أجزم بعد بذلك، فلا نحكم بصحّة الرواية ما لم يضمّ إليه ثقة في طبقته ؛ لجهالته.
الجهة الثانية : في ترجمته وأعلام أصحاب الرجال فيه . قال النجاشي رحمه الله :
سليمان بن سفيان أبو داوود المسترقّ المنشد ، مولى كندة، ثمّ بني عدي منهم، روى عن سفيان بن مصعب ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، وعن الزبال(1)، وعمّر إلى سنة إحدى وثلاثين ومئتين .
قال أبو الفرج محمّد بن موسى بن علي القزويني رحمه الله : حدّثنا إسماعيل بن علي الدعبلي ، قال : حدّثنا أبي ، قال: رأيت أبا داوود المسترقّ - وإنّما سُمّي المسترقّ لأنّه كان يسترقّ الناس بشعر السيّد في سنة خمس وعشرين ومئتين - يحدّث عن سفيان بن مصعب ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، ومات سليمان سنة إحدى وثلاثين ومئتين .(2)
وقال الشيخ في الفهرست في باب الكُنى:
أبو داوود المسترقّ ، له كتاب ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن ابن الزبير ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي داوود، وأخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي داوود، ورواه عبد الرحمن بن أبي نجران عنه(3) .
وقال الكشّي في رجاله - فيما روى في أبي داوود المسترقّ - :
قال محمّد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي داوود المسترقّ ، قال : اسمه سليمان بن سفيان المسترقّ ، وهو المنشد ، وهو ثقة (وفي بعض النسخ : وكان ثقة على ما نقل)، قال حمدويه : وهو سليمان بن سفيان بن السمط المسترقّ، كوفي ، يروي عنه الفضل بن شاذان ، أبو داوود المسترقّ مشدّدة، مولى بني أعين من كندة ، وإنّما سُمّي المسترقّ ؛ لأنّه كان راوية لشعر السيّد ، وكان يستخفّه الناس لإنشاده، يسترقّ أي يرقّ على أفئدتهم ، وكان يُسمّى المنشد،
ص: 187
وعاش تسعين سنة ومات سنة ثلاثين ومئة (وفي بعض النسخ : تسعين مكان سبعين على المنقول) .(1)
وذكره العلاّمة في القسم الأوّل من الخلاصة بقوله:
سليمان بن سفيان المسترقّ ؛ أبو داوود ، وهو المنشد ، وكان ثقة .(2)
ثمّ نقل بعض كلام حمدويه .
وقد نقل في التنقيح عن التحرير الطاووسي أنّ صاحب المعالم رحمه الله علّق على :
قوله (كان ثقة) ما لفظه : قلت: قوله (كان ثقة) من جملة كلام علي بن فضّال ، وربّما أوهمت عبارة هذا الكتاب أنّه من كلام الكشّي ، وليس كذلك ، وقد وقع التوهّم منها بالفعل في الخلاصة ، فجزم بتوثيقه ، ولا مأخذ له بحسب الظاهر إلاّ هذا .
فقال : غرضه بذلك أنّ الحسن بن علي بن فضّال ليس ثقة ؛ لكونه فطحياً ، فأجابه بأُمور : الأوّل: إنّا قد حقّقنا في ترجمته كون الرجل ثقة عدلاً إماميّا ، وأنّه إنّما كان فطحياً في بدو أمره ، وقضى أغلب عمره بالقول بإمامة الرضا عليه السلام ، فتوثيقه حجّة، واعتماد العلاّمة عليه وبناء توثيقه على توثيقه وجيه، سيّما وقد عدّه رحمه الله الخلاصة في القسم الأوّل ووثّقه، فلا اعتراض عليه في بناء توثيقه على توثيقه . وثانياً ... إلخ.(3)
أقول: لا يخفى عليك ما وقع له من الاشتباه بين الأب - أعني حسن بن علي بن فضّال - وابنه وهو علي بن حسن بن علي بن فضّال ؛ لأنّك قد عرفت أنّ المذكور في رجال الكشّي، هو علي بن الحسن بن علي بن فضّال . وهكذا ما نقله من صاحب المعالم ، ومع ذلك زعم أنّ التوثيق كان من الحسن بن علي بن فضّال ، الذي كان فطحيّا ورجع حين الموت ، على ما نقله النجاشي .
والحاصل ، أنّ الّذي وقع منه التوثيق، هو علي بن الحسن ، وهو كان فطحياً في جميع عمره ، ولم ينقل أنّه رجع من مذهبه ، ولكن كان فقيه الشيعة ووجههم وثقتهم،
ص: 188
ولهذا لا يضرّ انحرافه في المذهب بتوثيقه ، فيطمئنّ الإنسان من هذه الصفات بصدقه .
قال النجاشي:
علي بن الحسن بن علي بن فضّال بن عمر بن أيمن، مولى عكرمة بن ربعي الفيّاض،
أبو الحسن، كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم وثقتهم ، وعارفهم بالحديث، والمسموع قوله فيه، سمع منه شيئاً كثيراً ، ولم يعثر له على زلّة فيه ولا يشينه ، وقلّما روى عن ضعيف ، وكان فطحياً ... إلخ .(1)
وأمّا الناقل لهذا التوثيق أعني محمّد بن مسعود ، فهو أيضا ثقة، قال النجاشي:
محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السلمي السمرقندي، أبو النضر المعروف بالعيّاشي، ثقة، صدوق، عين من عيون هذه الطائفة ، وكان يروي عن الضعفاء كثيراً ، وكان في أوّل أمره عامّي المذهب ، وسمع حديث العامّة فأكثر منه ، ثمّ تبصّر وعاد إلينا وكان حديث السنّ ... . إلى آخر ما ذكره فيه .(2)
والحاصل ، أنّ التوثيق المزبور معتمد عليه ، وبناء العلاّمة توثيقه على توثيق ابن فضّال في محلّه ، وما سمعت من النجاشي في حقّه من أنّه: «لم يعثر له على زلّة فيه ولا يشينه ، وقلّما روى عن ضعيف» ، يدلّ على عظم شأنه وعلوّ درجته، فمن كان هذا شأنه فكيف يتردّد الإنسان في توثيقه ولا يضرّ كونه غير إمامي؛ لأنّ التّوثيق ليس من باب الشهادة حتّى يشترط فيه الإيمان والعدالة . ويؤيّد وثاقة الرجل أنّ الكشّي وحمدويه لم يلحقا كلام ابن فضّال بغمزٍ أو ردّ، فهذا مشعر برضائهما بتوثيقه.
فتلخّص: إنّ الرجل ثقة عدل، بشهادة علي بن الحسن بن علي بن فضّال، فلا مجال للتأمّل في ذلك كما وقع لصاحب المعالم . وقد نقل في التنقيح توثيق المجلسي رحمه الله في الوجيزة والبحراني في البلغة أيضا(3).
ص: 189
الجهة الثالثة : في سنة وفاته، وقد اختُلف فيه ، فقال النجاشي: «إنّه مات سنة إحدى وثلاثين ومئتين» ، وصرّح بذلك في موضعين من كلامه .
ويؤيّد ذلك أيضا ما ذُكر من أنّ أبا داوود كان يسترقّ الناس سنة خمس وعشرين ومئتين، هذا وقد ذكر حمدويه فيما تقدّم من أنّ أبا داوود مات سنة ثلاثين ومئة، فالتفاوت بينهما إحدى ومئة سنة ، ولكنّ الحقّ ما ذكره أبو العبّاس رحمه الله ؛ لأنّه يلزم على قول حمدويه أن يكون الرجل زمان الإمام الصادق عليه السلام ؛ لأنّه استشهد سنة ثمان وأربعون ومئة ، مع أنّه لم يروِ عنه عليه السلام إلاّ بواسطة سفيان بن مصعب العبدي وغيره، وأيضاً يبعد ذلك أنّه لم يعدّه الشيخ ولا غيره من الرجاليّين من أصحاب الصادق عليه السلام ، ويؤيّد ما ذكره النجاشي أنّ الرواة عنه كالدعبلي والفضل بن شاذان وعلي بن مهزيار وغيرهم من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام ، وبعضهم من أصحاب الرضا عليه السلام ، كابن أبي نجران وغيره ، فكيف يكون وفاته سنة ثلاثين ومئة وقد استشهد الرضا عليه السلام سنة ثلاث ومئتين ؟(1)
ص: 190
1 . الفوائد الرجالية (فوائد الوحيد البهبهاني) ، الوحيد البهبهاني الحائري (ت 1205 ه ) .
2 . الهداية في الأُصول والفروع ، الشيخ الصدوق (ت 381 ه ) ، تحقيق و نشر : مؤسّسة الإمام الهادي عليه السلام ، قمّ ، الطبعة الاُولى ، 1418 ه .
3 . الرواشح السماوية ، الميرداماد محمّد باقر الأسترآبادي (ت 1041 ه ) ، تحقيق : غلام حسين قيصريه ها ، قمّ : مؤسّسة دار الحديث ، الطبعة الاُولى ، 1422 ه .
4 . الرعاية في علم الدراية ، الشهيد الثاني (ت 965 ه ) ، تحقيق : عبد الحسين بقّال ، قمّ : مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي ، الطبعة الثانية ، 1408 ه .
5 . مجمع البحرين ، فخر الدين الطريحي (ت 1085 ه ) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، قمّ : مكتبة الثقافة الإسلامية ، الطبعة الثانية ، 1408 ه .
6 . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ه ) ، تحقيق و نشر : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قمّ ، الطبعة الثانية ، 1414 ه .
7 . الكليني والكافي ، عبد الرسول الغفّار (معاصر) ، طبع و نشر : مؤسّسة النشر الإسلامي ، قمّ ، الطبعة الاُولى ، 1416 ه .
8 . تعليقة على منهج المقال ، الوحيد البهبهاني (ت 1205 ه ) .
9 . الغيبة ، الشيخ الطوسي (ت 460 ه ) ، تحقيق : عباد اللّه الطهراني ، قمّ : مؤسّسة المعارف الإسلامية ، الطبعة الاُولى ، 1411 ه .
10 . أعيان الشيعة ، السيد محسن الأمين العاملي (ت 1371 ه ) ، تحقيق : حسن الأمين ،
بيروت : دار التعارف للمطبوعات ، 1403 ه .
11 . اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي) ، الشيخ الطوسي (ت 460 ه ) ، تحقيق : مهدي الرجائي ، قمّ : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث .
ص: 191
12 . خاتمة مستدرك الوسائل ، الميرزا حسين النوري الطبرسي (ت 1320 ه ) ، تحقيق و نشر : مؤسّسة آل البيت عليهم السلاملإحياء التراث ، قمّ ، الطبعة الاُولى ، 1415 ه .
13 . مستدركات علم رجال الحديث ، الشيخ علي النمازي الشاهرودي (ت 1405 ه ) ، طهران : شفق ، الطبعة الاُولى ، 1412 ه .
14 . عين الغزال في فهرس أسماء الرجال (رجال الميرزا فضل اللّه) ، الميرزا فضل اللّه حكيم إلهي اللواساني الطهراني (ت 1353 ه ) ، الطبعة الحجريّة بضميمة كتاب فروع الكافي ، طهران ، 1315 ه .
15 . مشرق الشمسين ، البهائي العاملي (ت 1031 ه ) ، قمّ : منشورات مكتبة بصيرتي ، يحتوي
على عدّة كتب ، وهي طبعة حجرية .
16 . أعيان الشيعة ، محسن الأمين العاملي (ت 1371 ه ) ، تحقيق : حسن الأمين ، بيروت :
دار التعارف للمطبوعات .
17 . كتاب من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق (ت 381 ه ) ، تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفّاري ، قمّ : مؤسّسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية .
18 . الكافي ، الشيخ الكليني (ت 329 ه ) ، تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري ، طهران : دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الخامسة ، 1363 ش .
19 . رجال النجاشي ، الشيخ النجاشي (ت 450 ه ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي ،
قمّ ، الطبعة الخامسة ، 1416 ه .
20 . رجال الطوسي ، الشيخ الطوسي (ت 460 ه ) ، تحقيق : جواد القيّومي ، قمّ : مؤسّسة النشر
الإسلامي ، الطبعة الاُولى ، 1415 ه .
21 . الفهرست للطوسي ، الشيخ الطوسي (ت 460 ه ) ، تحقيق : جواد القيّومي ، قمّ : مؤسّسة النشر الإسلامي ، الطبعة الاُولى ، 1417 ه .
22 . سماء المقال في علم الرجال ، أبو الهدى الكلباسي (ت 1356 ه ) ، تحقيق : السيّد محمّد الحسيني القزويني ، قمّ : مؤسّسة ولي العصر للدراسات الإسلامية ، الطبعة الاُولى ، 1419 ه .
23 . لسان العرب ، ابن منظور (ت 711 ه ) ، قمّ : أدب الحوزة ، 1405 ه .
ص: 192
24 . رسائل في دراية الحديث ، أبو الفضل حافظيان (معاصر) ، نشر وطبع : مؤسّسة دار الحديث ، الطبعة الاُولى ، 1424 ه .
25 . خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ، العلاّمة الحلّي (ت 726 ه ) ، تحقيق : جواد القيّومي ، قمّ : مؤسّسة النشر الإسلامي ومؤسّسة نشر الفقاهة ، الطبعة الاُولى ، 1417 ه .
26 . منتقى الجمان ، الشيخ حسن صاحب المعالم (ت 1011 ه ) ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ،
قمّ : مؤسّسة النشر الإسلامي ، 1406 ه .
27 . تنقيح المقال في علم الرجال ، الشيخ عبد اللّه المامقاني (ت 1351 ه ) ، تحقيق : محيي الدين المامقاني ، قمّ : نشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام ، الطبعة الاُولى ، 1424 ه . والطبعة الحجرية القديمة ، طهران : انتشارات جهان ، بوذر جمهري .
28 . توضيح المقال في علم الرجال ، الملاّ علي كني (ت 1306 ه ) ، تحقيق : محمّد حسين مولوي ، قمّ : نشر وطباعة دار الحديث ، الطبعة الاُولى ، 1421 ه .
29 . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول عليهم السلام ، العلاّمة المجلسي (ت 1111 ه ) ، تحقيق :
رسولي المحلاّتي وآخرون ، طهران : دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الاُولى ، 1370 ش .
30 . بصائر الدرجات ، محمّد بن الحسن الصفّار (ت 290 ه ) ، تحقيق : حسن كوچه باغي ، منشورات الأعلمي ، طهران ، الطبعة الاُولى ، 1404 ه .
31 . تاريخ بغداد (مدينة السلام) ، الخطيب البغدادي (ت 463 ه ) ، تحقيق : مصطفى عبد القادر
عطا ، بيروت : دار الكتب العلمية ، الطبعة الاُولى ، 1417 ه .
32 . طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال ، السيّد علي البروجردي (ت 1313 ه ) ، تحقيق : مهدي الرجائي ، قمّ : نشر مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي ، الطبعة الاُولى ، 1410 ه .
33 . هداية المحدّثين إلى طريق المحمّدين (مشتركات الكاظمي) ، محمّد أمين الكاظمي (القرن الحادي عشر الهجري) .
ص: 193
ص: 194
الراويات النساء من كتاب «الكافي» للكليني
سلمى حسين علوان الموسوي
صنّف الكليني رحمه الله كتاب الكافي في الأُصول والفقه ، فجمع فنون الأحاديث ، وأوعى ضروب الأخبار ، مرتّبا على أقسام المعرفة وأبواب التشريع وأنواع الأحكام ، نهض في تأليفه عشرين سنة في شأن تصنيف الكافي ، ولا يخفى أنّ تلك المدّة طويلة جدّا ، فلو كان الموضوع في التاريخ أو الآداب أو اللغة أو الأُصول ، لما احتاج إلى هذا الزمن المديد .
ولمّا كان تصنيفه في الحديث - وهذا يستوجب معرفة الراوي وكتبه وسيرته وتقلّب أحواله ومعرفة الرجال حال التحميل وحال الأداء ، إلى غير ذلك من الجرح والتعديل - فلا غرابة للشيخ أن يستهلك تلك المدّة لأجل تصنيف الكافي ، حيث كان يتحرّى الدقّة والضبط في الرجال والأسانيد والمتون والطرق ، وهذا بدوره يستلزم الإحاطة الكاملة بفنّ علم الرجال .
وشيخنا من خلال كتابه يكشف لنا مدى تضلّعه بهذا الوقف ، ودقّته في نقل الأسانيد والطرق المتعدّدة من غير خلط أو التباس ، بهذا أصبح المرجع الأوّل للطائفة . وحقّا أنّه لم يُصنّف مثله ، والذين جاؤوا بعده فهم عيال عليه .
ولأهمّية الكتاب حرص العلماء المعاصرون للمصنّف أن يقرؤونه عليه ، ويروونه عنه سماعا وإجازةً ، ومن لم يدركه أو لم يسعفه الحظّ أن يقرأه على الشيخ ، فقد قرأه
ص: 195
على تلميذه أبي الحسين أحمد الكوفي الكاتب الخاصّ له . وقد رواه جملة من أكابر علماء الشيعة عن شيوخ الطائفة وحملة فقه العترة الطاهرة ، كالنجاشي ، والصدوق ، وابن قولويه ، والسيّد المرتضى علم الهدى ، والشيخ المفيد ، وشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ، وهارون بن موسى التّلعُكبري ، وأبي غالب الزُّراري ، وغيرهم .
وهو - كما نعلم - حديثي كبير نفيس ، استقرأ السنن النبويّة والأحكام الشرعية والمأثور من علم أهل البيت عليهم السلام ، فأصاب الغرض وأتقن التأليف وأحاط بالأقطار الأثر ، ووفي تفاصيل الدين . ولمّا أكمل الكليني كتابه ، وأتمّ ردّ موادّه إلى فصولها ، بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت عليهم السلام ، ورسائل الأئمّة ، وآداب الصالحين ، وطرائف الحكم ، وأبواب العلم ممّا لا ينبغي تركه ، فألّف هذا المجموع الآنف وسمّاه «الروضة» ؛ لأنّ الروضة منبت أنواع الثمر ، ومعدن ألوان الزهر .
والروضة - على كلّ حال - مرجع قيّم ، وأصل شريف ، يعدّ من ذخائر الكتب ونفائس الأسفار ، وفيه من الرسائل والكتب والوصايا ونوادر العلم وجواهر المعارف ، ما يعاد على الدهور فيفضي إلى معادن السلامة ، ويبري العليل ويشفي الغليل ، وينوّر القلب ويهدي الصراط .
لقد أُحصيت الأحاديث للراويات النساء في كتاب الكافي (الأُصول والفروع والروضة) ، وكانت هي كما يلي :
الحديث الأوّل :
ورد في الجزء الثاني ، الصفحة 133 ، رقم 3 :
محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن رزق اللّه أبو عبد اللّه ، قال : حدّثني موسى بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر ، قال : حدّثتني حكيمة ابنة محمّد بن
ص: 196
علي عليه السلام - وهي عمّة أبيه - أنّها رأته ليلة مولده وبعد ذلك .
الحديث الثاني :
ورد في الجزء الثاني ، الصفحة 123 ، رقم 6 :
علي بن محمّد ، عن محمّد بن شاذان بن نعيم ، عن خادمٍ لإبراهيم بن عبدة
النيسابوري ، أنّها قالت : كنت واقفة مع إبراهيم على الصفا ، فجاء عليه السلام حتّى وقف على إبراهيم وقبض على كتاب مناسكه وحدّثه بأشياء .
الحديث الثالث :
ورد في الجزء الثاني ، الصفحة 141 ، رقم 22 :
علي بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن وهب بن شاذان ، عن الحسن بن أبي الربيع ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أُمّ هاني ، قالت : سألتُ أبا جعفر محمّد بن علي عليه السلام عن قول اللّه تعالى : «فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ» ؟ قالت : فقال : إمام يخنس سنة ستّين ومئتين ، ثمّ يظهر كالشهاب يتوقّد في الليلة الظلماء ، فإن أدركتِ زمانه قرّت عينكِ .
الحديث الرابع :
ورد في الجزء الثاني ، الصفحة 142 ، رقم 23 :
عدّة من أصحابنا ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمر بن يزيد ، عن الحسن بن الربيع الهمداني ، قال : حدّثنا محمّد بن إسحاق ، عن أسيد بن ثعلبة ، عن أُمّ هاني ، قالت : لقيت أبا جعفر محمّد بن علي عليه السلام ، فسألته عن هذه الآية : «فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ» ؟ قال : الخُنّس ، إمام يخنس في زمانه عند انقطاعٍ من علمه عند الناس سنة ستّين ومئتين ، ثمّ يبدو كالشهاب الواقد في ظلمة الليل ، فإن أدركتِ ذلك قرّت عينكِ .
الحديث الخامس :
ورد في الجزء الثاني ، الصفحة 151 ، رقم 3 :
ص: 197
علي بن محمّد ، عن علي بن محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن القاسم العجلي ، عن أحمد بن يحيى المعروف بكُردٍ ، عن عبد الكريم بن عمرو الخَثعَمي ، عن حَبابة الوالبيّة ، قالت : رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شُرطة الخميس ومعه دِرّة لها سَبابتان ؛ يضرب بها بيّاعي الجرّي والمارماهي والزِّمّار ، ويقول لهم : يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان ! فقام إليه فرات بن أحنف فقال : يا أمير المؤمنين ، وما جند بني مروان ؟ قال : فقال له : أقوام حلقوا اللحي وفتلوا الشوارب فمُسخوا . فلم أر ناطقا أحسن منه .
ثمّ اتّبعته ، فلم أزل أقفوا أثره حتّى قعد في رحبة المسجد ، فقلت له : يا أمير المؤمنين ، ما دلالة الإمامة يرحمك اللّه ؟ قالت : فقال : ائتيني بتلك الحصاة ، وأشار بيده إلى حصاة ، فأتيته بها ، فطبع لي فيها بخاتمه ، ثمّ قال لي : يا حبابة ، إذا ادّعى مُدّعٍ الإمامةَ فقدر أن يطبع كما رأيت ، فاعلمي إنّه إمام مفترض الطاعة ، والإمام لا يعزب عنه شيء يريده .
قالت : ثمّ انصرفتُ حتّى قُبض أمير المؤمنين عليه السلام ، فجئت إلى الحسن عليه السلام وهو في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام والناس يسألونه ، فقال : يا حبابة الوالبية! فقلت : نعم يا مولاي ، فقال : هاتي ما معك . قالت : فأعطيته ، فطبع فيه كما طبع أمير المؤمنين عليه السلام .
قالت : ثمّ أتيتُ الحسين عليه السلام وهو في مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فقرّب ورحّب ، ثمّ قال لي : إنّ في الدلالة دليلاً على ما تريدين ، أفتريدين دلالة الإمامة ؟ فقلت : نعم يا سيّدي ؛ فقال : هاتي ما معك . فناولته الحصاة ، فطبع لي فيها .
قالت : ثمّ أتيت عليّ بن الحسين عليه السلام وقد بلغ بي الكبر إلى أن أُرعشت وأنا أعدّ يومئذٍ مئة وثلاث عشرة سنة ، فرأيته راكعا وساجدا ومشغولاً بالعبادة ، فيئست من الدلالة ، فأومأ إليّ بالسبابة ، فعاد إليّ شبابي ، قالت : فقلت : يا سيّدي ، كم مضى من الدنيا وكم بقي ؟ فقال : أمّا ما مضى فنعم ، وأمّا ما بقي فلا . قالت : ثمّ قال لي : هاتي ما معكِ . فأعطيته الحصاة ، فطبع لي فيها .
ثمّ أتيت أبا جعفر عليه السلام ، فطبع لي فيها ، ثمّ أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام ، فطبع لي فيها ، ثمّ أتيت
ص: 198
أبا الحسن موسى عليه السلام ، فطبع لي فيها ، ثمّ أتيت الرضا عليه السلام فطبع لي فيها .
وعاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر على ما ذكره محمّد بن هشام .
الحديث السادس :
ورد في الجزء الثاني ، الصفحة 168 ، رقم 15 :
علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا - ذكر اسمه - ، قال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم ، قال : أخبرنا موسى بن إسماعيل بن عبد اللّه بن العبّاس بن عليّ بن أبي طالب ، قال :
حدّثني جعفر بن زيد بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قالوا : جاءت أُمّ أسلم يوما إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وهو في منزل أُمّ سلمة ، فسألتها عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فقالت : خرج في بعض الحوائج الساعة يجيء . فانتظرته عند أُمّ سلمة حتّى جاء صلى الله عليه و آله ، فقالت أُمّ أسلم : بأبي أنت وأُمّي يا رسول اللّه ، أنّي قد قرأت الكتب وعلمت كلّ نبيّ ووصيّ ، فموسى كان له وصيّ في حياته ووصيّ بعد موته ، وكذلك عيسى ، فمن وصيّك يا رسول اللّه ؟ فقال لها : يا أُمّ أسلم ، وصيّي في حياتي وبعد مماتي واحد . ثمّ قال : يا أُمّ أسلم ، من فَعَل فعلي هذا فهو وصيّي . ثمّ ضرب بيده إلى حصاة من الأرض ففركها بإصبعه فجعلها شبه الدقيق ، ثمّ طبعها بخاتمه ، ثمّ قال : من فَعَل فعلي هذا فهو وصيّي في حياتي وبعد مماتي .
فخرجتُ من عنده ، فأتيت أمير المؤمنين عليه السلام فقلت : بأبي أنت وأُمّي ، أنت وصيّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؟ قال : نعم يا أُمّ أسلم . ثمّ ضرب بيده إلى الحصاة ففركها فجعلها كهيئة الدقيق ، ثمّ عجنها وختمها بخاتمه ، ثمّ قال : يا أُمّ أسلم ، من فَعَل فعلي هذا فهو وصيّي .
فأتيت الحسن عليه السلام وهو غلام فقلت له : يا سيّدي ، أنت وصيّ أبيك ؟ فقال : نعم يا أُمّ أسلم . وضرب بيده وأخذ حصاة ففعل بها كفعليهما . فخرجت من عنده فأتيت الحسين عليه السلام - وأنّي لمستصغرة لسنّه - فقلت له : بأبي أنت وأُمّي ، أنت وصيّ أخيك ؟ فقال : نعم يا أُمّ أسلم ، ائتيني بحصاة . ثمّ فعل كفعلهم .
فعمّرت أُمّ أسلم حتّى لحقت بعليّ بن الحسين عليه السلام في منصرفة ، فسألته : أنت وصيّ أبيك ؟ فقال : نعم ، ثمّ فعل كفعلهم صلوات اللّه عليهم أجمعين .
ص: 199
الحديث السابع :
ورد في الجزء الثاني ، الصفحة 244 ، رقم 5 :
علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن حجرش ، قال : حدّثتني حكيمة بنت موسى عليه السلام ، قالت : رأيت الرضا عليه السلام واقفا على باب بيت الحطب وهو يناجي ولستُ أرى أحدا ، فقال : هذا عامر الزَّهرائي أتاني يسألني ويشكو إليّ . فقلت : يا سيّدي ، أحبّ أن أسمع كلامه ، فقال لي : إنّك إن سمعتِ به حُممت سنة ، فقلت : يا سيّدي ، أحبّ أن أسمعه ، فقال لي : اسمعي . فاستمعت شبه الصفير ، وركبتني الحُمّى فحُممت سنة .
الحديث الثامن :
ورد في الجزء الرابع ، الصفحة 338 ، رقم 2 :
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن ثابت ، عن أسماء ، قالت : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من أصابه همّ أو غمّ أوكرب أو بلاء أو لأواء ، فليقل : اللّه ربّي ولا أشرك به شيئا ، توكّلت على الحيّ الذي لا يموت .
الحديث التاسع :
ورد في الجزء الأوّل ، الصفحة 452 :
الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الفارسي ، عن أبي حنيفة محمّد بن يحيى ، عن الوليد بن أبان ، عن محمّد بن عبد اللّه بن مُسكان ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إنّ فاطمة بنت أسد جاءت إلى أبي طالب لتبشّره بمولد النبيّ صلى الله عليه و آله ، فقال أبو طالب : اصبري سَبتا ، أُبشّرك بمثله إلاّ النبوّة . وقال : السبت ثلاثون سنة ، وكان بين
رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين عليه السلام ثلاثون سنة .
وقد ورد ذكرها في حديث آخر هو :
علي بن محمّد بن عبد اللّه ، عن السابري ، عن محمّد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : إنّ فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين كانت أوّل
ص: 200
امرأة هاجرت إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله من مكّة إلى المدينة على قدميها ، وكانت من أبرّ الناس برسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فسمعت رسول اللّه وهو يقول : إنّ الناس يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدوا ، فقالت : واسوأتاه ، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله : فإنّي أسأل اللّه أن يبعثك كاسية .
الحديث العاشر :
ورد في الجزء الأوّل ، الصفحة 341 ، رقم 6 :
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إنّ الحسين بن علي عليه السلام لمّا حضره الذي حضره ، دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين عليه السلام ، فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة ، وكان علي بن الحسين عليه السلام مبطونا معهم لا يرون إلاّ أنّه لِما به ، فدفعت فاطمة الكتاب إلى عليّ بن الحسين عليه السلام ، ثمّ صار واللّه ذلك الكتاب إلينا يا زياد . قال : قلت : ما في ذلك الكتاب جعلني اللّه فداك ؟ قال : فيه ما يحتاج إليه ولد آدم منذ خلق اللّه آدم إلى أن تفنى الدنيا ، واللّه أنّ فيه الحدود ، حتّى أنّ فيه إرش الخدش .
الحديث الحادي عشر :
ورد في الجزء الأوّل ، الصفحة 358 ، رقم 17 :
بعض أصحابنا ، عن محمّد بن حسّان ، عن محمّد بن رنجويه ، عن عبد اللّه بن الحكم الأرمني ، عن عبد اللّه بن إبراهيم بن محمّد الجعفري ، قال : أتينا خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام نعزّيها بابن بنتها ، فوجدنا عندها موسى بن عبد اللّه بن الحسن ، فإذا هي في ناحية قريبا من النساء ، فعزّيناهم ، ثمّ أقبلنا عليه ، فإذا هو يقول لابنة أبي يشكر الراثية : قولي (أي انشدي مرثية) ، فقالت :
اعدُد على رسول اللّه *** أسد الإله وثالثاً عبّاسا
واعدُد عليَّ الخير واعدُد جعفرا *** واعدُد عقيلاً بعده الرُّوَّاسا
ص: 201
فقال : أحسنتِ وأطربتني ، زيديني . فاندفعت تقول : ... إلخ .
الحديث الأوّل :
ورد في الجزء السادس ، الصفحة 198 ، رقم 4 :
أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قالت عائشة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ أهل بريرة
اشترطوا ولاءها ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الولاء لمن أَعتَقَ .
الحديث الثاني :
ورد في الجزء الثالث ، الصفحة 42 ، رقم 6 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن أُمّه وأُمّ أحمد بنت موسى ، قالتا : كنّا مع أبي الحسين عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغدٍ الجمعة ؛ فإنّ الماء غدا قليل . فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة .
الحديث الثالث :
ورد في الجزء الثالث ، الصفحة 181 ، رقم 3 :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مهاجر ، عن أُمّه أُمّ سلمة ، قالت : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر ثمّ صلّى على الأنبياء ودعا ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمّ كبّر الرابعة
ودعا للميّت ، ثمّ كبّر وانصرف ، فلمّا نهاه اللّه عزّوجلّ عن الصلاة على المنافقين ، كبّر وتشهّد ثمّ كبّر وصلّى على النبيّين صلّى اللّه عليهم ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف ، ولم يدعُ للميّت .
ص: 202
الحديث الرابع :
ورد في الجزء الثالث ، الصفحة 179 ، رقم 1 :
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سُئل : كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : يَصفُفن جميعا ولا تتقدمهنّ امرأةٌ .
وورد اسمها في رواية أُخرى من الجزء الثالث ، الصفحة 225 ، رقم 8 :
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن عليّ بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : لا ينبغي الصياح على الميّت ولا شقّ الثياب .
الحديث الخامس :
ورد في الجزء الخامس ، الصفحة 311 ، رقم 32 :
أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي زهرة ، عن أُمّ الحسن ، قالت : مرّ بي أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أيّ شيء تصنعين يا أُمّ الحسن ؟ قلت : أغزل ، فقال : أما أنّه أحلّ الكسب - أو من أحلّ الكسب .
الحديث السادس :
ورد في الجزء الخامس ، الصفحة 381 ، رقم 9 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد اللّه الكاهلي ، قال : حدّثتني حَمّادة بنت أُخت أبي عُبيدة الحذّاء ، قالت : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ تزوّج امرأةً وشرط لها أن لا يتزوّج عليها ورضيت ، إنّ ذلك مهرها ؟ قالت : فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلاّ على درهمٍ أو درهمين .
الحديث السابع :
ورد في الجزء الخامس ، الصفحة 526 ، رقم 3 :
علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن سالم ، عن بعض أصحابه ، عن الحكم بن مِسكين ، قال : حدّثتني سعيدة ومِنّة أُختا محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري ، قالتا : دخلنا
ص: 203
على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلنا : تعود المرأة أخاها ؟ قال : نعم ، قلنا : تصافحه ؟ قال : من وراء الثوب . قالت إحداهما : إنّ أُختي هذه تعود إخوتها ، قال : إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المُصَبّغة .
وورد رواية أُخرى في الجزء الخامس ، الصفحة 555 ، رقم 4 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيدة ، قالت : بعثني أبو الحسن عليه السلام إلى امرأة من آل زبير ؛ لأنظر إليها أراد أن يتزوّجها ، فلمّا دخلت عليها حدّثتني هُنيئةً ثمّ قالت : أَدني المِصباح ، فأدنيته لها ، قالت سعيدة : فنظرت إليها وكان مع سعيدة غيرها ، فقالت : أرضيتنّ ؟ قال : فتزوّجها أبوالحسن عليه السلام ، فكانت عنده حتّى مات عنها ، فلمّا بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه وثيابه ، وهو ساكت يضحك ولا يقول لهنّ شيئا ، فذُكِرَ أنّه قال : ما شيءٌ مثلَ الحرائر .
الحديث الثامن :
ورد في الجزء السادس ، الصفحة 40 ، رقم 2 :
محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد بن
العبّاس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أُمّه أُمّ إسحاق بنت سليمان ، قالت : نظر إليّ أبو عبد اللّه عليه السلام وأنا أُرضع أحد بني محمّد أو إسحاق ، فقال : يا أُمّ إسحاق ، لا ترضعيه من ثديٍ واحد ، وارضعيه من كليهما ، يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا .
الحديث التاسع :
ورد في الجزء السادس ، الصفحة 369 - 370 ، رقم 1 :
محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن فاطمة بنت علي ، عن أُمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأُمّها زينب بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، قالت : أتاني أمير المؤمنين عليّ عليه السلام في شهر رمضان ، فأُتِي بعشاءٍ وتمرٍ وكَمأةٍ ، فأكل عليه السلام وكان يحبّ الكمأة .
ص: 204
الحديث العاشر :
ورد في الجزء السادس ، الصفحة 384 ، رقم 3 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن عمٍّ لعمر بن يزيد ، عن بنت عمر بن يزيد ، عن أبيها ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم اللّه ثمّ شرب ، ثمّ قطعه فقال : الحمد للّه ، ثمّ شرب فقال :
بسم اللّه ، ثمّ قطعه فقال : الحمد للّه ، ثمّ شرب فقال : بسم اللّه ، ثمّ قطعه فقال : الحمد للّه ، سبّح ذلك الماء له مادام في بطنه إلى أن يخرج .
الحديث الحادي عشر :
ورد في الجزء السادس ، الصفحة 199 ، رقم 4 :
بكر بن محمّد ، عن جويرة ، قالت : مرّ بي أبو عبد اللّه عليه السلام وأنا في المسجد الحرام أنتظر مولىً لنا ، فقال : يا أُمّ عثمان ، ما يقيمك هاهنا ؟ فقلت : أنتظر مولىً لنا ، فقال :
أعتقتموه ؟ فقلت : لا ، فقال : أعتقتم أباه ؟ قلت : لا ، أعتقنا جدّه ، فقال : ليس هذا
مولاكم ، بل هذا أخوكم .
الحديث الثاني عشر :
ورد في الجزء السادس ، الصفحة 198 ، رقم 1 ، حديث آخر عنها ، هو :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء ، عن الحسن بن مسلم ، قال : حدّثتني عمّتي ، قالت : إنّي جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد اللّه عليه السلام ، فلمّا رآني مال إليّ فسلّم عليَّ فقال : ما يجلسك هاهنا ؟ فقلت : أنتظر مولىً لنا . قالت : فقال لي : أعتقتموه ؟ قالت : لا ولكن أعتقنا أباه ، فقال : ليس ذلك
مولاكم ، هذا أخوكم وابن عمّكم ، إنّما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه وجدّه فهو ابن عمّك وأخوك .
الحديث الثالث عشر :
ورد في الجزء السادس ، الصفحة 413 ، رقم 1 :
ص: 205
محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد اللّه بن وضّاح ، عن أبي بصير ، قال : دخلت أُمّ خالد العبدية على أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده ، فقالت : جُعلت فداك ، إنّه يعتريني قَراقر في بطني ، وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسَّويق ، وقد وقفت وعرفت كراهتك له ، فأحببت أن أسألك عن ذلك . فقال لها : وما يمنعك عن شربه ؟ قالت : قد قلّدتك ديني ، فألقى اللّه عزّوجلّ حين ألقاه فأخبره أنّ جعفر بن محمّد عليه السلام أمرني ونهاني . فقال : يا أبا محمّد ، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل ؟ لا واللّه لا آذن لكِ في قطرةٍ منه ، ولا تذوقي منه قطرة ، فإنّما تندمين
إذا بلغت نفسك هاهنا - وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا - أفهمت ؟ قالت : نعم . ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما يَبُلّ الميلَ يُنَجِّسُ حُبّا من ماءٍ - يقولها ثلاثا - .
الحديث الرابع عشر :
ورد في الجزء السابع ، الصفحة 55 ، رقم 10 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن هشام بن أحمر وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا ، عن سالمة مولاة أبي عبد اللّه عليه السلام ، قالت : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام حين حضرته الوفاة ، فأُغمي عليه ، فلمّا أفاق قال : أُعطوا الحسن بن علي بن الحسين - وهو الأفطس - سبعين دينارا ، وأُعطوا فلانا كذا وكذا ، وفلانا كذا وكذا . فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة ؟ فقال : ويحكِ! أما تقرئين القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : أما سمعتِ قول اللّه عزّوجلّ : «وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِى أَن يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» ؟
قال ابن محبوب في حديثه : "حمل عليك بالشفرة" ، يريد أن يقتلك . فقال : أتريدين على أن لا أكون من الذين قال اللّه تبارك وتعالى : «وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِى أَن يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» ، نعم يا سالمة ، أنّ اللّه
خلق الجنّة وطيّبها ، وطيّب ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاقّ ولا قاطع رحم .
ص: 206
وللكليني في منهجه بسند الحديث ومتنه أُمور ، منها :
إنّه روى عن النساء كما ذكرنا سابقا . ومن منهجه أنّه يجتزئ الحديث ويذكر ما اجتزأ منه في بابٍ آخر ؛ لتوفّر المناسبة بين البابين ، كالحديث في كتاب الحجّة في باب الغيبة :
عن الحسن بن أبي الربيع ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أُمّ هاني(1) .(2)
ومن منهجه تعدّد رواة الطبقة الواحدة ، أي يروي عن أكثر من راوٍ واحد في أيّ طبقة من طبقات السند التي يؤدّي إليها علمه ، وأكثر ما يكون هذا التعدّد في طبقة شيوخه أو الطبقة التي تروي عن الإمام من أهل البيت ، وفي هذا دليل على كثرة سماعه من الشيخ ومصاحبته لهم ، كروايته :
عن محمّد بن الحسن ، قال : دخلت أُمّ خالد العبدية على أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده ... إلخ .(3)
ومن فوائد هذا المنهج في السند هو تلافي ضعف الرواية الناشئ من السند لأسبابٍ مختلفة ، كضعف أحد رواتها ، أو وجود عبارات مجهولة في السند ، مثل «عمّن حدّثه» أو «عمّن رواه» ، أو وجود مجهول لم تذكره كتب الرجال ، وغير ذلك من أسباب التضعيف الناشئ من السند . وعليه ، فإنّ الإكثار من طرق الرواية يجبر مثل هذا الضعف في أحاديث الفروع .
وللكليني معرفة واسعة بأسماء الرجال وبلدانهم وألقابهم وكُناهم ، ولا غرابة في ذلك إذا كان من بين مؤلّفاته كتاب سمّاه «الرجال» ، وتظهر هذه المعرفة جلية واضحة فيما ذكره عن رجال سنده في أحاديث الفروع من الكافي ، حيث لم يقتصر فيها على
ص: 207
أسمائهم ، بل يضيف لهذه الأسماء ما يُعرف بها من كُنية أو نسب أو لقب ، نسبة إلى مدينة أو قبيلة أو صنعة أو حرفة . ومن أمثلة ما ذكره من الاسم والكُنية قوله :
حدّثتني حمادة بنت الحسن أُخت أبي عُبيدة الحذّاء .(1)
وقد يتوسّع في ذكر نسب الراوية ، وقد يحذف الاسم مكتفيا بما يدلّ عليه من كُنية أو لقب وغير ذلك ، كقوله في حديث «زينب العطّارة الحولاء» .(2)
وكثير ما يذكر حرفة الراوية وصنعتها التي اشتهرت بها ، كقوله «العطّارة» .(3)
أو ما يبيعه الراوي ، فقد حفي باهتمام الكليني ، فيذكره مع الاسم ، كقوله : «بيّاع السابري» ، ويذكر العاهة أيضا «الحولاء» ، وأحيانا يذكر اسم الراوية مضيفا له أحد رسمه ، كأن يكون أخاه ، كقوله : «عن إسماعيل الأرقط وأُمّه أُمّ سلمة أُخت أبي عبد اللّه» .
وقد يذكر الكليني الراوية مع شيء عن أحوالها ، كقوله : «خادم لإبراهيم بن عبدة النيسابوري» .(4) وربّما يكتفي بتعيين بلد الرواة بدلاً عن أسمائهم ، كقوله في مولد أمير المؤمنين عليه السلام : «عن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن عجب الفارسي» .(5)
ويبدو من خلال تسمية رجال السند أنّ الحركة الفكرية لذلك العصر لم تكن حكرا على طبقة معيّنة من الناس ، بل اشتركت عدّة فئات من المجتمع في تطويرها ، وليس أدلّ عليه من أصحاب الحرف والصناعات والتجّار في تعاطي الحديث وروايته .(6)
ص: 208
ومن تتبّع أسانيد الفروع تظهر أمانة الكليني في نقل الحديث وروايته ، وذلك بالتزامه بألفاظ مشايخ السند واحدا عن آخر ونقلها كما هي ، كروايته عن «حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام »(1) .
ويبدو أنّ الكليني لم يغفل مثل هذا الإسناد الضعيف للرواية ، فحاول تقوية الروايات التي وقع في طريقها مثل هذا التردّد أو الظنّ ، وذلك بروايته بطرق أُخرى موصولة إلى إمامٍ ، يظهر ذلك من متابعة مواقع الروايات المذكورة وما رواه قبلها أو بعدها من الباب نفسه بأدنى تأمّل . ومن أمثلته ما قوّى به روايته مثلاً .
ومن منهجه في السند هو اختصاره خشية الإطالة ، لاسيّما عند تكرار نفس الموادّ في أحاديث الباب الواحد ، وكثيرا ما يعبّر عن بعض الرواة بلفظ «العدّة» ، أو «الجماعة» ، قائلاً : «عدّة من أصحابنا» ، وهو يريد بهذا التعبير مجموعة من الرواة بأعيانهم أُطلق عليهم هذا اللفظ بدلاً من التنصيص على اسم كلّ واحدٍ منهم ، غايته بذلك الاختصار .
ومنهجه في اختصار السند لم يجرِ بصورة منتظمة بجميع أجزاء الفروع ، ونراه في حديث بنت عمر بن يزيد ،(2) وذكر المفيد أنّها(3) مجهولة . وتعقيبا نقول ، إنّ المصادر المجهولة التي وقع في إسنادها اسم «عدّة من أصحابنا» وهو ما يسمّى في الحديث «الحديث المبهم» ، وأنّ الكليني روى عن «بنت عمر بن يزيد» وهي مجهولة ، ولكنّ الكليني رواها بطريق موصول عن أبيها ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
فنجده تارةً يختصر السند المكرّر برجاله في السند اللاّحق ، وأُخرى يذكره بتمامه ، وهو نوع من تكرار الأسانيد ، كما لم يرتّب الأسانيد المتماثلة ترتيبا متسلسلاً
ص: 209
حتّى يمكن اختصارها بعبارته : «وبهذا الإسناد» ، فقد يحصل لديه أن يتكرّر السند نفسه بتمام رجاله في روايةٍ لاحقة ، وعندئذٍ يمكن اختصاره ، ولكنّه قد يتكرّر هذا السند في الرواية الخامسة أو السادسة من الباب نفسه ، وحينئذٍ يضطرّ إلى ذكره كاملاً .
ومن منهجه هو انقطاع أسانيد الكافي وإرسالها ، وربّما يعمّم هذا القول فيشمل سائر محدّثي الإمامية الاثني عشرية عند بعض المسلمين ، ومرجع هذا الاشتباه هو الجهالة بسند الحديث المنتهي إلى الإمام من غير اتّصاله ظاهرا بالرسول الكريم صلى الله عليه و آله ، هل هو من قبيل المتّصل أو من قبيل المرسل أو المنقطع ؟ كالأحاديث التي ينتهي سندها إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام في كتب الأُصول الأربعة لدينا .
والحقيقة التي تؤخذ - بهذا الموضوع - من كلام الأئمّة أنفسهم بشأن أحاديثهم أنّها موصولة السند برسول اللّه صلى الله عليه و آله ، حيث أعطوا قاعدة عامّة لسندهم في الحديث ، فقد روى الكليني بسنده :
عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وغيره ، قالوا : سمعنا أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدّي ، وحديث جدّي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن ، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين ، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله وحديث رسول اللّه قول اللّه عز و جل .(1)
وعليه ، فإنّ ما ثبت صدوره من متون الروايات عن الإمام لم يصرّح برفعها إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فهي ليست من باب المنقطعة أو المرسلة كما تقدّم ، وإنّما تعتبر موصولة السند من هذه الناحية .
ويرى الكليني أنّ الروايات المأخوذة عن النبيّ صلى الله عليه و آله لا باعتبار سند الإمام في الحديث ، وإنّما باعتبار آخر يقوم على أساس ما ثبت لديهم من حجّية سند أهل البيت لعصمتهم .
ص: 210
وبهذا نرى أنّه استطاع بمهارته أن يوفّر - بكثرة - الأبواب ، يريد بهذا لمن أراد الاطّلاع على معرفة حكمٍ ما من أحاديث أهل البيت بسهولة ويسر ، وذلك لاستنباط عناوين هذه الأبواب من مضامين أحاديثها ، بل إنّ كثيرا من أبواب الفروع مشعرة بنوعية الحكم الموجودة في تلك الأحاديث ، وقد يكرّر الكليني الأحاديث في فروع الكافي كثيرا ، ولم يسلك طريقة واحدة إزاء ما كرّره من متون الأحاديث ، فهو يختصر المتن المكرّر لديه بسندٍ واحد ، كما في حديث جويرة الذي جاء عن طريق :
بكر بن محمّد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي ، أبو محمّد ، وجه في هذه الطائفة من بيتٍ جليل بالكوفة ... وكان ثقة ، وعمّر عمرا طويلاً ، له كتاب .(1)
وبهذا يستدعي مراعاة تسلسل الأحاديث وترتيبها في الباب الواحد. وعدّه البرقي من أصحاب موسى بن جعفر الذين أدركو الإمام الصادق(2) ، وعدّه الطوسي من
أصحاب الصادق ، وأُخرى من أصحاب الكاظم ، وثالثةً من أصحاب الرضا ، ورابعةً ممّن لم يروِ عن الأئمّة ،(3) وهذا سهو من قلمه .
ويتّضح من ترجمته أنّه بعيد عن زمن الكليني ، ممّا يرجع روايته عن أصله المذكور سابقا ، وهو حديث جويرة بنت الحارث بن مالك بن جزيمة ، وجزيمة هو المصطلق من خُزاعة ، تزوّجها مُسافع بن صفوان فقُتل يوم المريسيع .(4)
في هذا المبحث تطرّقت إلى معرفة أسماء الراويات النساء وأحوالهنّ العامّة والخاصّة ، حتّى نصل إلى عدالتهنّ ومقدار تمكّنهنّ من ضبط رواية الحديث . ولذلك ينبغي أن يُراعى بالطبقات عنصر الزمان أوّلاً ، وكانت السابقة إلى الإسلام نقطة
ص: 211
الانطلاق الزماني ، وفي أهل البيت عليهم السلام ، وفي الإمام علي عليه السلام الذي أعاد إلى الأذهان أحاديث نبويّة تبرز حقّه بالخلافة بلا منازع .
ومثلما ظهر هناك من وضوح وتركيز في استعراض حقّه خاصّة ، يظهر هنا في شأن أهل البيت ، ففي خطبة الإمام :
انظروا أهل بيت نبيّكم ، فالزموا سمتهم ، واتبعوا إثرهم ، فلن يخرجوكم من هدى ، ولن يعيدوكم في ردى ... فإن لبدوا فالبدوا ، وإن نهضوا فانهضوا ... ولا تسبقوهم فتضلّوا ، ولا تتأخّروا عنهم فتهلكوا .(1)
من تلك النصوص النبويّة الثابتة ، وخلاصتها في نصّ الثقلين ونصّ الغدير والاثني عشر خليفة ، أصبحت الإمامة في أهل البيت تعيّنا في عليّ عليه السلام بعد الرسول الكريم صلى الله عليه و آله مباشرةً .
لذلك كان الكليني كغيره من علماء الإمامية يعتبر الروايات المأخوذة عن أئمّة أهل البيت هي كالروايات المأخوذة عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، لا باعتبار سند الإمام في الحديث ، وإنّما باعتبارٍ آخر يقوم على أساسٍ ثابت لديهم من حجّية سنّة أهل البيت لعصمتهم ، ومعنى هذا عندهم أنّ بيان الإمام لأيّ حكمٍ شرعي لا يمكن أن يكون غير مطابق للواقع ، وهو لا يختلف عن بيان أبيه .
والمهمّ أن نعلم أنّ الرسول صلى الله عليه و آله قال :
خير القرون قرني ، ثمّ الذين يلونهم ، ثمّ الذين يلونهم .(2)
ثمّ ذكر الكليني أحاديث عن الصحابيات ثمّ التابعات . ورواياته ليست أحادية المذهب ، وهذا يدلّ على الروعة العلمية في عصره ، من حيث اتّساع رواية الحديث بتعدّد المصادر ، وأصحابها جميعا من الثقات . فلا موجب للتوقّف إزاءها .
ص: 212
أمّا طبقات الراويات في كتاب «الكافي» وفروعه فهي :
من أهل البيت الراويات :
أُمّ الحسن ، قالت : مرّ بي أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أيّ شيء تصنعين يا أُمّ الحسن ؟
قلت : أغزل ، فقال : أما أنّه أحلّ الكسب ... إلخ .(1)
وحديث آخر جاء برواية أُمّ الحسين بن موسى وأُمّ أحمد بنت موسى ، قالتا :
كنّا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا ليوم غدٍ يوم الجمعة ؛ فإنّ الماء غدا قليل . فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة .(2)
وراوية حديث حكيمة ابنة محمّد بن علي عليه السلام ، وهي عمّة موسى بن محمّد ابن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام ، قالت : «إنّها رأته ليلة مولده وبعد ذلك» .(3)
وراوية أُخرى من أهل البيت عن محمّد بن حجرش ، قال :
حدّثتني حكيمة بنت موسى عليه السلام ، قالت : رأيت الرضا عليه السلام واقفا على بيت الحطب وهو يناجي ، ولستُ أرى أحدا ... إلخ .
باب أنّ الجنّ يأتيهم فيسألون عن معالم دينهم ويتوجّهون في أُمورهم .
أمّا الصحابيات اللاّئي تحدّثن فهنّ كثيرات في كتاب الكليني ؛ إنّ الصحابي من :
صحب النبيّ صلى الله عليه و آله مؤمنا ومات على ذلك ، وطريقة معرفته التواتر ، والشهرة ، والاستقامة ، وإخباره ثقة .(4)
وأكثر العلماء : الواجب في ذلك حمله على أنّ الصحابي من محبّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فقال قوم : يجوز كونه راويا عن غيره ، والأظهر هو القول الأوّل . وكذلك قول الصحابي :
حدّث أو أخبر أو قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » ، فهو بمثابة قوله : «سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يأمر
ص: 213
بكذا أو ينهي عن كذا» .(1)
ومن راوياته التابعيات ، وهنّ من لقي الصحابيات ، ثمّ الراويات والمروي عنهنّ إن استويا في السنّ أو في اللقاء ، فهو النوع الذي يقال له : رواية الأقران .(2)
إذا كان الكليني متبعا من سبقه في طريقة تصنيف الكتاب ، فإنّه استطاع بمهارته أن يوفّر - بكثرة الأبواب - مزيد الجهد لمن أراد الاطّلاع على معرفة حكمٍ ما من أحاديث أهل البيت عليهم السلام بسهولة ويسر ، وذلك لاستنباط عناوين هذه الأبواب مضامين أحاديثها . إنّ الكثير من أبواب الفروع مشعرة بنوعية الحكم الموجودة في تلك الأحاديث ، وقد استخدم الكليني لتصنيف الحديث طريقتين مشهورتين عند العلماء :
الأُولى : طريقة الأبواب ، وكيفيتها أن يقوم بتقسيم الكتاب على مجموعة كتب ، كلّ منها يحتوي على عدد من الأبواب التي يضع ما لديه من الأحاديث موزّعة عليها ، وقد تمّت دراسة الراويات النساء في كتاب الأُصول ، وكانت كما يلي :
في كتاب الحجّة باب «تسمية من رآه عليه السلام » ، برواية حكيمة بنت محمّد بن عليّ عليه السلام .(3)
في كتاب الحجّة باب «تسمية من رآه عليه السلام أيضا» ، برواية خادم لإبراهيم بن عبدة النيسابوري .(4)
في كتاب الحجّة باب «في الغيبة» ، ورد حديثان برواية أُمّ هاني .(5)
ص: 214
في كتاب الحجّة باب «ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل في أمر الإمامة» ، برواية أُمّ أسلم(1) ، قالوا : «جاءت أُمّ أسلم يوما إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وهو في منزل أُمّ سلمة(2) ، فسألتها عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ...» إلخ .
في كتاب الحجّة باب «أنّ الجنّ يأتيهم فيسألون عن معالم دينهم ويتوجّهون في أُمورهم» ، برواية حكيمة بنت موسى عليه السلام .(3)
في كتاب الحجّة باب «في الغيبة» ، برواية حبابة الوالبية .(4)
في كتاب الدعاء باب «الدعاء للكرب والهمّ والحزن والخوف» ، برواية أسماء .(5)
في كتاب الدعاء باب «الإشارة والنصّ على عليّ بن الحسين صلوات اللّه عليهما» ، برواية فاطمة بنت الحسين بن علي عليه السلام .(6)
كتاب الحجّة باب «ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل في أمر الإمامة» ، برواية خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام .(7)
أمّا فروع الكافي ، فإنّ السمة البارزة فيه هي سمة فقهية ملازمة لها في جميع أبوابها وأحاديثها ، إلاّ في القليل النادر منها ، ولا يخفى أنّ هذا التبويب والترتيب لهذه المجموعة الكثيرة من الأحاديث جاء نتيجة لنظرة الكليني الفقهية باعتباره فقيهاً
ص: 215
مجدّداً في عصره ، مضافاً إلى تأثّره بمن سبق من أعلام المحدّثين بهذه الطريقة من التصنيف .
أمّا ما ورد من الراويات النساء في فروع الكافي فهنّ كالتالي :
في كتاب العتق والتدبير والكتابة باب «الولاء لمن أعتق» ، برواية عائشة زوج الرسول صلى الله عليه و آله .(1)
في كتاب الجنائز باب «علّة تكبير الخمس على الجنائز» ، برواية أُمّ محمّد بن مهاجر أُمّ سلمة .(2)
في كتاب الطهارة باب «وجوب الغسل يوم الجمعة» ، برواية أُمّ الحسين بن موسى وأُمّ أحمد بنت موسى .(3)
في كتاب الجنائز باب «صلاة النساء على الجنازة» برواية امرأة الحسن الصيقل .(4)
في كتاب المعيشة باب «النوادر» برواية أُمّ الحسن عليهاالسلام .(5)
في كتاب النكاح باب «نوادر في المهر» ، برواية حَمّادة بنت الحسن أُخت أبي عبيدة الحذّاء .(6)
في كتاب النكاح باب «مصافحة النساء» ، برواية سعيدة ومِنّة أُختا محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري .(7)
وبهذا نرى أنّ الروايات في فروع الكافي آراء واجتهادات كثيرة ، هي غالبا ما تكون
ص: 216
لرواة مشهورين من أصحاب الأئمّة ، وتأتي هذه التعقيبات توضيحا لمرامي النصّ وأهدافه ، أو بيان موقفه من تعارض مروياته ، أو التماس وجها آخر للرواية المخالفة حكمها للإجماع ، وغير ذلك .
إنّ تحميل الرواية جاء أكثرها عن طريق شيوخه ، وهم :
1 - محمّد بن يحيى أبو جعفر العطّار القمّي ، قال النجاشي :
هو شيخ أصحابنا في زمانه ، ثقة عين ، كثير الحديث ، له كتب .(1)
وهو من شيوخ الكليني وروى عنه(2) ، ومن رجال عدّته الذين يروي بتوسّطهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وقد أكثر الرواية في (2778) موردا ، منها ثلاثة موارد بعنوان محمّد بن يحيى العطّار ، وفي جميع موارده من النساء والتي جاءت تحت عنوان محمّد بن يحيى ، هي :
قال عنه : حدّثتني حَمّادة بنت الحسن أُخت أبي عُبيدة الحذّاء» في كتاب فروع الكافي : ج 5 ، ص 381 ، ح 9 .
وقال عنه : «حدّثتني أُمّ إسحاق بنت سليمان في ... إلخ» : ج 6 ، ص 40 ، ح 2 .
وقال عنه : «حدّثتني فاطمة بنت أبي العاص بن الربيع وأُمّها زينب بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ج 6 ، ص 369 - 370 .
وقال : «حدّثتني حكيمة ابنة محمّد بن عليّ عليه السلام » : ج 2 ، ص 122 ، ح 3 .
2 - علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمّي ، وثّقه النجاشي(3) قائلاً : ... ثقة في الحديث ، ثبت معتمد ، صحيح المذهب ، سمع فأكثر ، وصنّف كتبا . وهو من أهمّ شيوخ الكليني(4) ومن رجال عدّته التي تروي عنه . وقد جاءت في رواية : عن ابن
ص: 217
أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : جاءت فاطمة عليهاالسلام تشكو إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعض أمرها ، فأعطاها رسول اللّه صلى الله عليه و آله كُرَيسةً وقال : تعلّمي ما فيها . فإذا فيها : مَن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ، ومن يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت .(1)
بعد هذا التطواف مع راويات الكليني ال (26) ، لابدّ من وضع خاتمة نوضّح فيها ما شهدته الحضارة الإسلامية في جميع أشواطها ، أسماء لامعة برزت فيها النساء في مختلف المجالات ، التي تطرّق لها الكليني في كتابه الكافي ، ويمكن إرجاع سبب اتّخاذه المرأة كمحدّثة واعتماد روايتها ، يعود إلى البيئة السياسية التي عاشها الكليني رغم الاضطرابات في الحكم ، إلاّ أنّها لم تؤثّر على شخصيته العلمية ، وأظهر أنّ المذاهب الإسلامية في حقيقتها وحدة متراصّة وأنّ الاختلاف لا يفسد من الودّ قضية ، فهو اختلاف في الرأي والمنهج ، وأنّ الجميع تكاتف لمصلحة الإسلام .
وكذلك كان الكليني الذي تناول راويات من مختلف المذاهب والأقطار والأزمان ، وكان شيوخه ليس جميعا من الثقات والمعروفين ، لكنّ حكمه عليهم جميعا بالصحيحين ؛ لأنّ مرويّاتهم صدورها عن الأئمّة من آل البيت عليهم السلام ، لذا يقضي إعادة النظر في تصنيف الأحاديث في السند والرواية ، وخاصّة عند تبنّيه الإكثار من طرق الرواية واختصار السند .
استطاع الكليني إبراز الراويات الرائدات مسلمات زاولن ضروبا متنوّعة من المعرفة الإسلامية في الرواية ، بمثال عملي عن إمكانية المرأة المسلمة وأهليتها للارتقاء في درجات العلم دون حدود .
ص: 218
1 . أُسد الغابة في معرفة الصحابة ، عزّ الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير (ت 630 ه )، القاهرة ، 1286 ه .
2 . أُصول الكافي لثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ، عبد الحسين عبد اللّه المظفّر ، شرح وتصحيح وتعليق وتنقيح : مطبعة النعمان ، النجف الأشرف : 1956 م .
3 . أحاديث أُمّ المؤمنين عائشة ، السيّد مرتضى العسكري ، إيران : التوحيد للنشر ، 1994 م .
4 . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار ، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (ت 1110 ه ) ، بيروت : مؤسّسة الوفاء ، 1983 م .
5 . رجال ابن داوود ، الحسن بن علي الحلّي (ت 737 ه ) ، طهران ، 1342 ه .
6 . رجال البرقي ، أحمد بن محمّد البرقي الكوفي (ت 274 ه ) ، طهران : جامعة طهران ،
الطبعة الأولى ، 1342 ش .
7 . رجال الطوسيّ ، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسيّ (ت 460 ه ) ،
النجف الأشرف : 1961 م .
8 . رسائل في رواية الحديث ، أبو الفضل حافظيان البابلي ، قمّ : دار الحديث ، 1424 ه .
9 . روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات ، محمّد باقر الموسوي الخوانساري ، بيروت : دار الكتاب العربي ، 1390 ه .
10 . الإصابة في معرفة الصحابة ، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر (ت 822 ه ) ، القاهرة : شركة مطبعة ومكتبة مصطفى محمّد البابي وأولاده ، 1939 م .
11 . فجر الإسلام ، أحمد أمين ، القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 1955 م .
ص: 219
12 . الكافي ، أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329 ه ) ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، ثمانية أجزاء ، طهران : دار الكتب الإسلامية ، 1363 ش .
13 . كتاب الكفاية في علم الرواية ، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463 ه ) ، تحقيق : محمّد عمر هاشم ، بيروت : دار الكتاب العربي ، 1985 م .
14 . معالم العلماء ، أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن عليّ بن شهر آشوب المازندراني (ت 588 ه ) ، النجف الأشرف : 1961 م .
15 . المفيد من معجم رجال الحديث ، محمّد الجواهري ، قمّ : مكتبة محلاّتي ، 1424 ه .
16 . الموجز في علوم الحديث ، مساعد مسلم آل جعفر ، بغداد : دار الرسالة للطباعة ، 1978 م .
17 . نهج البلاغة ، ما اختاره أبو الحسن الشريف الرضي محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي من كلام الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام (ت 406 ه ) ، شرح : محمّد عبده ، قمّ : دار الذخائر ، 1412 ه .
18 . الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (764 ه ) ، بيروت : جمعية المستشرقين الألمانية ، دار صادر ، 1969 م .
ص: 220
إحداثيات الفكر الاثني عشري بين الكليني والصدوق
دراسة فلسفية - كلامية
د. علي حسين الجابري
لا تُعرف مواقع المدن على الأرض، ولا مواقع النظرية الكلامية والفلسفية والعلمية على خارطة الأفكار، إلاّ بمعرفة الإحداثيات، بعدّها مفهوماً افتراضياً له علاقة بعلم تحديد المكان والحدث والجماعة ، هكذا نظر الباحث إلى أهمّية الشيخ الكليني والشيخ الصدوق ، في الفكر الاثنا عشري قبل أحد عشر قرناً ، ولاسيّما خلال فترة الغيبة الصغرى للإمام الثاني عشر(عج) ومابعدها ، على صعيد الفكر والحضارة والعقيدة، بعد دراسات له امتدّت طوال أربعة عقود ونيّف في دائرتي الزمان والمكان والفلسفة، ولاسيّما - وهذا هو المهمّ - أنّ الأعلام المبحوثين، قد توزّعوا على أنشطة مدرسة قمّ الحديثية، ومدرسة بغداد المجدّدة، من خلال تشعّب مباحث ذات صلة بحياة الناس وعقائدهم، كان من بين علاماتها الفارقة - على صعيد الفلسفة - الفارابي (ت 339 ه ) ، وإخوان الصفا (المدرسة البصرية) المعروفة في الفترة ذاتها ، وما مهّد لذلك من أنشطة ذات شأن كبير لدولة طبرستان العلوية وامتداداتها في الدولة الزيدية (اليمن) و(المهدية - الفاطمية) في الشمال الأفريقي، ووصول بني بويه إلى مركز القوّة والتأثير في بغداد (الدولة العبّاسية) للمدّة من 334 ه - 447 ه ، وماتركته جميع هذه
ص: 221
المتغيّرات من آثار على سيرورة العقيدة الاثنا عشرية .
إنّ الحديث عن ظروف الاثنا عشرية خلال الغيبة الصغرى لوحده - وهو ميدان حركة الكليني - كافٍ للدلالة على صخب الأحداث وخطر السياسة على رجال هذا الفكر الذي جاء عصر الصدوق؛ الميدان البديل على صعيد حركة الدولة - إلى حدٍّ ما - ، بما وفّر قدراً من الحرّية استقطب أنشطة رجال هذه المدرسة، فكان الشيخ المفيد (ت 413ه ) واحداً من أكبر أعلام الاثنا عشرية في بغداد ، يعدّ رأس المثلّث لزاويتي المثلّث الاُولى الشيخ الكليني ، والثانية الشيخ الصدوق ، وعلى هذا المثلّث استقام البناء الكلامي والفلسفي والعقيدي عند الاثنا عشرية .
حاول الباحث التوسّل بالمصادر وهو يلملم مادّة هذه الدراسة ؛ ليستكمل بها حلقات البحث الاثنا عشري (شخصيات - مدارس - اتّجاهات) ، ويسهم مع الباحثين الآخرين في الوفاء بصاحب الذكرى وهو يمهّد في حفظ موارد العقيدة في عصرٍ عاصف لا يثبت فيه إلاّ المتمسّك بالأثر، والمحافظ على الخبر والعارف بمسالك طريق الأئمّة عليهم السلام الموصل إلى المنبع الأوّل (النبيّ صلى الله عليه و آله ) الذي أخذ الإسلام من خالق كلّ شيء عزّ وجلّ .
وليس أجمل من ذكرى مفكّر سار على هديه آخرون، واستدلّ بدربه السائرون إلى يوم الدين ، فذلك هو الوهج العقيدي والكلامي الذي كان ومازال وسوف يبقى، متألّقاً في الآفاق ... فالجميع يعلم أنّ الشيخ الكليني قد مهّد بالكافي وهو في الحقبة الاُولى (الغيبة الصغرى) لما سيكون عليه الحال في الحقبة الثانية (الغيبة الكبرى) ، التي حاول الصدوق فيها أن يكمل مشروع الكليني كما يكمل دور مدرسة قمّ فيها دور مدرسة بغداد الحديثية في كتاب من لا يحضره الفقيه .
فنحن إذا نتحدّث عن شخصيات فكرية شمولية لها شيوخ ولهم تلاميذ حملوا لواء الكلمة المكتوبة والتشبّث بها، استجابةً لوصايا الأئمّة عليهم السلام بعدّهم حلقات مترابطة تعود إلى عصر الرسالة (الحلقة النبويّة) ، وهي تترجم نداء الوحي الإلهي إلى الناس
ص: 222
كافّة ، وتُوضّح مراميه وتُفرّع أُصوله، بفضل السنّة النبويّة وما استودعه الشارع عند (العترة الطاهرة) خلفاً عن سلف لسلسلة متماسكة الحلقات معروفة الرواة ، وصولاُ بها إلى صاحب الزمان عَجّل اللّه فرجه .
لهذا نقول : إنّ الحقبة الاُولى غير الحقبة الثانية، مختلفتان في الجوانب الفلسفية والاجتماعية والحضارية، مع ذلك استدرك الصدوق على ما فات الكليني ، وكلاهما سارا على الأثر بالفكر الاثنا عشري بين إيقاعين محافظ ومجدّد، وما دمنا نتحدّث عن حقبة انتقالية في المسيرة الإمامية الكلامية ، فبماذا سنخرج من سياحتنا في خارطة الفكر الاثنا عشري بين عصر الكليني وعصر الصدوق ؟ سؤل سنحاول الإجابة عليه في هذا البحث المتواضع. ومن اللّه التوفيق والسداد.
عُرف الكليني باتّجاهه السلفي (المحافظ)، أو كما سُمّي بالأخباري، والأخبارية بالمعنى المخصّص الذي أُطلق على أتباع الاتّجاه الحديثي المحافظ داخل الفكر الإمامي الاثنا عشري الذي يعود إلى عصرهم - الأئمّة الاثنا عشر - فهم تبع لهم في علومهم، عن الكتاب والسنّة وأخبار السلف.
وإذا كان مفهوم السلف عام تفاوت فيه وحوله الرأي عند عموم المسلمين، فإنّه عند الإمامية الاثنا عشرية محدّد بالأئمّة عليهم السلام إلى يوم الدين، وإن هو انحصر - زماناً ومكاناً - في القرون الثلاثة الاُولى من الهجرة النبويّة الشريفة.
وإذا ما أردنا تحديد هذه الحقبة الزمانية بالجغرافية (المكان) قلنا : إنّ مثلث (المدينة المنوّرة - الكوفة - قمّ) هي المراكز التي استقطبت النشاط الإمامي الحديثي، وصولاً به إلى بغداد وسامراء ! بعدّها تجليّات لمدرسة الصادق عليه السلام (ت 148 ه ) التي بلغت مدياتها القرون والأماكن إلى يوم الناس هذا.(1)
ص: 223
والأخباريون، جماعة اعتمدوا على موارد حديثية موزّعة على مئات الكتب، استخلصها الكليني في الكافي وروضته،(1) والصدوق (ت 381 ه ) في كتابه كتاب من لايحضره الفقيه، والشيخ أبو جعفر الطوسي (ت 460 ه ) في كتابيه، التهذيب والاستبصار، التي استغنى فيها عن التوثيق التفصيلي عن الرواة كافّة، منوّهاً بالمجروحين.(2)
إنّ منهج المحدّثين والأخباريّين، كما يقول الغريفي، يتمسّك بالأخبار المحفوفة بتلك القرائن ، ولأجله صحّح الكليني والصدوق حجّية الأخبار التي في كتابيهما (الكافي والفقيه) ، وإن كان فيها الضعاف بلحاظ السنّة قائلاً عن الكليني : ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهماالسلام .(3)
ونقل الفيض الكاشاني عن الصدوق قوله في مقدّمة الوافي :
بل قصدت إلى ، ايراد ما أفتي وأحكم بصحّته وأعتقد به أنّه حجّة فيما بيني و(بين) ربّي .
لذلك علّق عليه الفيض قائلاً :
فقد جرى صاحبا كتابي (الكافي والفقيه) على ما تعارف عليه المتقدّمون في إطلاق الصحيح، على ما يركن إليه ... فحكما بصحّة جميع ما أورداه في كتابيهما من الأحاديث، وإن لم يكن كثير منه صحيحاً على مصطلح المتأخّرين(4) .
ولخّص لنا الأعلمي في موسوعته حقيقة الموقف المحافظ لمدرسة الأئمّة عليهم السلام ، حتّى عدّ أربعة آلاف رجل روى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، كما وجده عند ابن عقدة في رجاله، وهناك من روى عن الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين ، صعوداً إلى الحجّة (عج) ، حتّى تجمّع ما سمّي بالأُصول الأربعمئة من تلامذة نجباء ثقاة، كلّها
ص: 224
بسندٍ ينتهي إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، وهكذا صعداً إلى المهدي فالسفراء الأربعة، إلى أن وصل إلى أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني، محيي طريقة أهل البيت عليهم السلام على رأس المئة الثالثة ، ويقصد الرابعة في مؤّفه الكافي ، وقيل إنّه عُرض على الحجّة (عج) ، فقال : «كافٍ لشيعتنا» .
وإنّ من طريقته وضع الأحاديث المخرّجة على أبواب على الترتيب بحسب الصحّة والوضوح... ووقع في الأواخر ما كان مجملاً(1) سمّاه باب النوادر .
وإذا كنّا قد أرجأنا الحديث عن مجريات الأحداث وملابساتها في القرن الثالث الهجري (زمن الغيبة الصغرى) إلى الصفحات اللاّحقة ، ووقفنا هنا عند النشاط الحديثي في القرن الرابع الهجري (الزمن المشترك بين الشيخين، الكليني والصدوق) ، يلفت نظرنا ذلك الجهد الكثيف لوفرة ما تيسّر له من الرواة واجتمع له من الكتب ، فما أخرجه الكليني من الأحاديث في الكافي وما تبعه به الآخرون ، دليل على إثرائها .
في الوقت الذي انبرى فيه جماعة من الإمامية لنقد الحديث، قام به رجال مثل أبي عبد اللّه محمّد بن خالد البرقي، ومحمّد بن أحمد بن داوود القمّي، وأحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بابن عقدة ، وغيرهم ممّن نوّهوا بالمذمومين من الرواة والممدوحين ،(2) لقد شهد العصر البويهي - مقابل سدّ باب الاجتهاد عند أهل السنّة - نشاطاً ملحوظاً، بفضل فتح بعض فقهاء الإمامية هذا الباب، مستغلّين وفاة السفير الرابع ودخول الاثنا عشرية عصر الغيبة الكبرى، بعد عام (329 ه ) وصل حدّ المبالغة في المراسيم الشيعية باختراع الجديد منها .(3) لكنّ الواضح على خارطة الفكر الاثنا
ص: 225
عشري من المعالم المعرفية المحافظة، مدرستان: الاُولى محافظة، والثانية مجدّدة للأصالة ، هما :
مدرسة قمّ الحديثية وامتداداتها في بغداد وصولاً بها إلى أيّام الشيخ المفيد (ت 413 ه ) ومحاولاته في فكّ التداخل مع الفكر المعتزلي. والثانية: مثلها في بغداد بعد نشاط (الصدوق) كلّ من الشيخ المفيد، والشريف المرتضى، وصولاً إلى الشيخ الطوسي (ت 460 ه ) وكتبه الحديثية، المنوّه بها سابقاً، ممّا تقع في معظمها خارج حدود هذه الدراسة، إلاّ على سبيل الإشارة. وتكاد الاُولى تكون جماع الموقفين (المحافظ والمجدّد) بعد أن احتوت نشاط كلّ من الكليني والصدوق.
أمّا ممهّدات الغيبة الصغرى الفكرية والسياسية التي كانت وراء (منعطفات عقيدية) كبرى ، فلا مجال للإفاضة فيها هنا ، نوجز بعضها:
أوّلاً : قيام ثورة الكوفة (249 - 250 ه /863 - 864م) ، والتي انتهت بهروب الثوّار إلى مشارق الدولة الإسلامية وجنوبها ، كما حصل لآل الحسن بن علي عليه السلام وأبناء الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام المنطلقين أصلاً من عقيدة لاتعترف بالمهادنة مع سلطة الاستبداد، ولاتقرّ إلاّ بإمامة القائم بالسيف، نتج عنها مايأتي :
1 - قيام الدولة العلوية في طبرستان (317 - 271ه ) التي تركت آثارها السياسية والعقيدية على مساحة واسعة من خارطة الإمبراطورية الإسلامية(1) ، كان من أهمّها :
أ . قيام الدولة الزيدية في اليمن عام (287 ه /900م).
ب . قيام الدولة الفاطمية في تونس (المهدية) عام (298 ه ) ، وفي الشمال الأفريقي وصولاً إلى (مصر) وبلاد الشام .
2 - بفضل الأنشطة العقيدية لرجال الدولة العلوية، ولاسيّما الجهود الفكرية التي
ص: 226
بذلها الحسن الناصر الكبير (ت 304 ه ) بدخول أكثر من مليون مواطن إلى دائرة الإسلام، كان من بينهم أولاد بويه الذين سيكون لهم دور مشهود في القرن الرابع الهجري ، حين مدّوا نفوذهم إلى بلاد خراسان وصولاً إلى بغداد ، ليفتحوا بذلك عصراً جديداً أمام الاثنا عشرية (امتدّ من 334 - 447 ه /945 - 1053م) . كانت أنشطة الصدوق تجري في ظلالها ، أو مستفيدة منها بشكلٍ من الأشكال، وهو يتنقّل بين مدرسة قمّ وبغداد .
ثانياً : إنّ شدّة المتغيّرات التي رافقت الأحداث المذكورة ، ولاسيما مطلع القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ، قد :
1 - انعكست على العديد من سياسات الخلفاء العبّاسيين في أواخر الحقبة التركية ، في تشديدهم على الأئمّة عليهم السلام وأتباعهم ، ولاسيّما في بغداد وسامراء والكوفة، فكان ما كان من وقائع انتهت باستتار الإمام الثاني عشر (عج) في غيبته الصغرى.
2 - صاحب ذلك اضطراب الأوضاع في البحرين والبصرة ؛ بسبب تزايد حركات القرامطة (من الإسماعيلية) وحركة الزنج ، ممّا عصف بهيبة الدولة العبّاسية، ووضع المجتمع على كفّ عفريت ؛ بسبب عدم معرفة القادم من الآثار المدمّرة لهذه الحركات ، على الرغم من الطابع الاجتماعي الذي يسودها، حتّى أفرزت لنا المرحلة مدرسة فكرية سرّية في الربع الأوّل من القرن الهجري الرابع في البصرة (إخوان الصفا)، عبر رسائل فلسفية بلغت (51) رسالة .
وهي ذات الأجواء التي غادر بسببها الفارابي بغداد عام 329 ه-/940م إلى حلب حيث الدولة الحمدانية ؛ ليستكمل مشروعه الإصلاحي هناك في كتابه المدينة الفاضلة ، إلى حين وفاته عام 339 ه-/950م.
إنّها أواخر الحقبة التي فقد فيها العنصر التركي سطوته على الخلافة العبّاسية في بغداد، وتعقّدت الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية، بعد أن شهد مدخل القرن
ص: 227
الرابع الهجري (301 - 309ه- /913 - 921م) أطول محاكمة في تاريخ الدولة الإسلامية ، انتهت بإعدام الحلاّج بالطريقة المعروفة، التي حملت عنوان مأساة الحلاّج،(1) لأسباب سياسية تحت ذرائع دينية.
وفلسفياً يمكن ملاحظة الأنشطة المكثّفة لإقامة مجتمع (فلسفي - روحي) ينأى بالناس فوق أخطاء السياسة وغلواء المتطرّفين والمتعسّفين من شتّى الأسماء المعروفة. وإذا كانت ممهّدات الغيبة الصغرى وتداعياتها في بيت الحكمة قد بسطتها يراع الكندي (ت 252 ه- ) وصولاً إلى أبي بكر محمّد بن زكريا الرازي (ت 320ه ) والفارابي، لكنّ البحث الكلامي عند الإمامية (الجعفرية - الاثنا عشرية) حافظ على التزامه بخطّ الأئمّة عليهم السلام السلفي إلاّ ما ندر .
ويبقى الحدث الأكبر الذي قلب الحسابات جميعاً مع بداية الغيبة الكبرى هو انتهاء العصر التركي وبدء حقبة جديدة من السياسة جاءت لصالح الفكر الاثنا عشري، الذي سبق ونافح الكليني عنه وبقية الرهط المحافظ من رجال الاثنا عشرية ، ولاسيّما في قمّ المقدّسة ، لتقود سلسلة المتغيّرات في ظلّ تمكّن آل بويه من زمام الأُمور في المشرق وبغداد ، كناتج تاريخي لما حقّقته دولة طبرستان العلوية التي بقي تأثيرها في بلاد الديلم والجيل حتّى منتصف القرن الرابع الهجري ، إلى جانب دورها في قيام الدولة الزيدية في اليمن والدولة الفاطمية والمهدية في الشمال الأفريقي ، وصولاً إلى القاهرة وقيام الجامع الأزهر ، كما نوّهنا بذلك في السطور السالفة.
جميع هذه المتغيّرات في مشرق الدولة الإسلامية ومغربها وجنوبها، هي ثمرة لجهود الثوّار الذين غادروا العراق(2) باتّجاه الشرق ، والتي توّجت بعيد وفاة الكليني
ص: 228
عام 329ه-/940م ببدء العهد البويهي.
لقد وجد الخضري أنّ الشيعة الإمامية الاثنا عشرية قد تنفّسوا الصعداء مع المرحلة الجديدة للمرّة الاُولى بعد سلسلة من الظروف القاسية التي عاشوها ، ولاسيّما في العراق والتي يعرفها الجميع ، وقبيل بلوغ هذه المرحلة كان الكليني واحداً من أبرز الرجال الذين خدموا هذا الفكر ، ولاسيّما من خلال علاقته بالسفراء الأربعة الذين لم يكونوا بعيدين عن روح التململ الاثنا عشري انتظاراً للظرف الجديد، على الصعد الكلامية والفلسفية.(1)
لقد أتاح الجوّ السياسي في هذه المرحلة (بين عصري الكليني والصدوق) نوع من الحرّية للاثنا عشرية ، تحدّث عنها أكثر من مفكّر(2) بعد أن لوحظ تشجيع البويهي للشعراء الذين وجدوا الفرصة مناسبة لإطلاق العنان لعواطفهم الدينية، بعد قرون من الكبت والاضطهاد والمطاردة والحجر على العقيدة.(3) إنّ جملة المتغيّرات - بعد الغيبة الصغرى - قد تمخّض عنها سلسلة من الحقائق العلمية والكلامية ، من بينها:
1 - ازدهار البحث العلمي، ووضوح الموقف الإمامي، بفضل تمايز العلوم والفنون وعدم التداخل بين مسائلها ووضوح المذاهب الإسلامية، بما كتب في أُصول العقائد فيها .(4)
2 - تخطّى المجتمع البغدادي خطر الانفجار و(الحرب الطائفية) أو الانهيار، من جراء الوضع الجديد على قاعدة من القناعة بتداولية الحكم العبّاسي بين الطائفتين، يقول الدكتور عبد الرزّاق محي الدين : فليرض أهل السنّة بتنفّس الإمامية الصعداء مادام ذلك يبقي لهم مذاهبهم ومراكزهم في الفتيا والقضاء، وليقنع الإمامية الاثنا
ص: 229
عشرية بهذا المكسب الناقص عن بلوغ دعوتهم، فإنه خير لهم على كلّ حال من العصور السابقة .(1)
وإن لم يدم مثل هذا التوافق سوى ربع قرن على الحقبة البويهية، ولاسيما في السنة 349ه-، مهّدت - بعد قرن من الزمن - لبدء الدور السلجوقي التركي في بغداد(2) ، لسنا في معرض الإفاضة عن حوادثه ومجرياته ، لكنّنا سنتأمّل فلسفياً وكلامياً أدوار كلّ من الكليني في الحقبة الاُولى، والصدوق ومدرسة قمّ في الحقبة الثانية ؛ لكي نخرج من دائرة العموم إلى خصوص البحث، ولكي تكتمل إحداثيات خارطة الفكر الاثنا عشري زماناً ومكاناً ومدارس وشخصيات وحوادث وأحداث، وهو أمر يدخل في غاية الباحث وطبيعة المناسبة التي نحتفي من خلالها بالشيخ الكليني ومنهجه الكلامي ومنظوره الفكري على سبيل التكامل.
ثالثاً : الدور الفكري للكليني في زمن السفراء الأربعة .
دأب السفراء الأربعة - على التوالي - تنظيم علاقة العلماء الأعلام من الاثنا عشرية بالإمام المستتر (عج) لأسباب قاهرة ، حيث غلب منطق التمسّك بالأثر، بعدّةٍ منجاة من كلّ خلل ، ودليل استقامة في العقيدة، والوثوق بموارد الحقيقة الشرعية إن كان على الصعيد الكلامي أو الفقهي - العملي ، هكذا استقام الحال في بغداد وسامراء والكوفة منذ عام (260 - 329 ه- / 873 - 940م) ، وفي مثل هذه الأجواء نشأ الكليني واستقام عوده وتكاملت ثقافته وتصوّراته وقناعاته ، ليخرج على الطالبين ب- :
أ - كلام يستظّل بظلّ النصّ والحديث النبويّ الشريف والخبر المعصومي الموثوق.
ص: 230
ب - قضايا عملية تتّصل بفروع الدين وتطبيقات الشريعة ، كما وردت عن السلسلة المعصومية.
ذلك هو الخطّ الذي تبنّاه الكليني، سمته النظر إلى النصّ المقدّس من خلال الأثر ، حيث عرف الاثنا عشرية بطريقة تفسير النصّ بالأثر(1) الوارد من مدرسة الأئمّة عليهم السلام في المدينة المنوّرة، منذ زمن السجّاد والباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام ... وامتداداتها في العراق ، وصولاً إلى مدرسة قمّ الحديثية ، موضوع المبحث الثاني، في بلاد المشرق وفارس(2) ، بفضل ظروف إيجابية صاحبت المتغيّرات السياسية المذكورة، إن كانت في دولة طبرستان حيث جهود الحسن الناصر الأطروشي الكبير (ت 304 ه ) ، أو جهود الكليني في بغداد، التي أثمرت حلولاً إيجابية تستجيب لمشيئة الاثنا عشرية، ورغبة البويهيين لاحقاً ، حيث ازدهر خلالها خطّ محافظ حرص أصحابه على التواصل مع روح العقيدة الإسلامية غير الرسمية ذات المنابع المستقلّة عن سطوة السياسة والسلطة والحكم ، تعزّزت بعد انتهاء حقبة سفارة السفير الرابع عام 329ه- /940م ، بعده العامّ الأكثر أهمّية في تاريخ الفكر الاثنا عشري اللاحق ، فما هي طبيعة المنهج الذي تبنّاه الكليني في هذه الحقبة؟ أعني في مؤّفاته ، ولاسيما كتاب الكافي ، الذي عدّ واحداً من أهمّ موارد الاثنا عشرية ؛ لثقتهم بصاحبه وصلته المباشرة بسفراء الإمام الثاني عشر (عج) ، كما يقول ابن طاووس.(3)
ونوّهنا قبل قليل بما وجده الشيخ الخضري(4) بعد وصول سلطة البويهيين إلى بغداد من أثر إيجابي على مجمل الاتّجاه الفكري والعقيدي للاثنا عشرية ، لا بسبب شيعية البويهيين ، بل بفضل الجهود التي بذلها الحسن الناصر الكبير في دولة
ص: 231
طبرستان من أثر ، التي كان طابعها الظاهري زيدي، مع آل الحسن الفارّين إلى هناك، بعد فشل ثورة الكوفة عام 250ه- /864م ؛ خوفاً من بطش صاحب شرطة بغداد البساسيري، الذي شتّت جموع الثوّار عند واسط ، فلم يجدوا أمامهم من ملاذ غير بلاد الجيل والديلم ، ليقيموا دولتهم هناك عام 271ه-/884م ومابعدها، والتي امتدّ أثرها إلى اليمن والشمال الأفريقي، وصولاً إلى عهد الناصر الكبير في (301 - 304ه- /913 - 916م) الذي حكم الدولة العلوية(1) هناك بعد كلّ من الحسن بن زيد ومحمّد بن زيد، وصولاً إلى الحسن بن القاسم (ت 316ه- ) والذي انتهت سيادة هذه الدولة بمقتله ، وتراجع النشاط الشيعي في هذه الربوع.
ولعلّ الكليني قد زامن أحداث بغداد التي توّجت عام (309ه- /921م) بإعدام الحلاّج لذرائع عقيدية لا تخلو من دوافع سياسية تتعلّق بإسماعيلية الحلاّج!
نقول هذا من غير أن نهمل البراءة التي أعلنها ابن الهمّام في بغداد عام 312ه-/924م على لسان السفير الرابع الحسين بن روح مع تكفير الصمغاني، قارنا إلحاده بما أُشيع عن الحلاّج من عقائد تتقاطع مع العقيدة الإمامية(2) - الاثناعشرية. عضّد ذلك الموقف (التحوّطي) للاثنا عشرية، في مثل ظروف بغداد تحت ظلّ السيطرة الأشعرية، ماكتبه الشيخ المفيد (ت 413 ه ) من رسالة في الردّ على أصحاب الحلاّج(3) ، وذلك في عام (393ه-/1003م) بما يلفت نظرنا عن سبب طرد القمّيين للحلاّج حين زار المدينة بتأثير ابن بابويه القمّي الذي كان وثيق الصلة ببغداد وسامراء ، أي مع الكليني وسفراء المهدي (عج) ، وقام بضرب الحلاّج في قمّ ومنعه من الترويج لخزعبلاته، بعد أن قدّم نفسه لأهل قمّ باعتباره وكيل صاحب الزمان (عج) ، كذلك أخفق في استمالة كبير الإمامية الاثنا عشرية أبا سهل إسماعيل بن
ص: 232
نوبخت(1) ، وجميع ذلك كان يعرفه الشيخ الكليني وهو يؤّخ لحقبة الغيبة الصغرى :
1 - إنّ الخطّ المحافظ - السلفي - اتّخذ مجراه الواضح ممثّلاً بنشاط المحدّثين والمشتغلين بالرواية، وكان على رأس هؤاء الشيخ الكليني(2) الذي كان معاصراً لفترة الوكلاء الأربعة للمهدي (عج) ، وهم : عثمان بن سعيد العمري، وولده أبو جعفر محمّد، وأبو القاسم الحسين بن روح، وعلي بن محمّد السمري (الخلاّني) ، وكانت صلتهم به بمثابة تزكية له وتوثيق مع أخبار وصلت عن اتّصاله بالمهدي .(3)
تلمّذ لأبي علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمّي(4) (ت 306 ه ) ، وخير ما قدّمه الكليني لخدمة الفكر السلفي، هو كتابه الكافي في الحديث ، الذي جرى فيه على طريقة السلف الصالحين، من ذكر جميع السند غالباً .(5)
2 - إنّ كتاب الكافي في علوم الدين، يتناول جميع العقائد الإمامية ومذاهبها، ويعدّ أحد الكتب الأربعة الكبرى الشيعية (الاثنا عشرية) وأوّلها ، ويشتمل على أكثر من (16) ألف حديث ، وعليه شروح كثيرة(6) ، كما له تلخيص يحمل عنوان (روضة الكافي) بقلم الكليني نفسه.
3 - سار على خطّ الشيخ الكليني، تلامذته من رجال مدرسة بغداد ، مثل:
أ . ابن عقدة (ت 333 ه ) ؛ أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي المشهور بابن عقدة الشيعي ، الذي قيل عنه إنّه من أصحاب الحديث(7) ، ساهم في نقد الرواة .
ص: 233
ب . ابن زينب النعماني ؛ (محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن جعفر النعماني(1) ، وهو أحد تلامذة الكليني المشهورين(2). صنّف عام (342 ه / 953 م) كتاب الغيبة، والفرائض ، والردّ على الإسماعيلية وتفسير الإمام جعفر الصادق عليه السلام وكتاب الدلائل(3).
ج . العمّاني ؛ (أبو علي الحسن بن علي بن أبي عقيل)، وقيل (أبو محمّد العمّاني والحذّاء)، ويقال له أيضاً: ابن أبي معروف العمّاني، ترك كتباً في الفقه والكلام حتّى وصفه البعض بأنّه : «أوّل من هذّب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن الأُصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى»(4)، وإن خالف العمّاني المنهج السلفي للكليني، لكنّه كان واحداً من ظاهرة التجديد في تلك الحقبة، أكمل جهود جماعة من الإمامية، مارسوا نقد الحديث لإزالة كلّ شكّ من جهة (وسائط) الأئمّة عليهم السلام، ولتكون مادّة موثوقة الاستعمال، مثل أبي عبد اللّه محمّد بن خالد البرقي ومحمّد بن أحمد بن داوود القمّي وغيرهم ممّن تحدّث عن المذمومين والممدوحين من الرواة(5)، ونوّهنا ببعضهم سابقاً.
وطوّر الخطّ النقدي للحديث والرواة في هذه الحقبة أبو حنيفة الشيعة (محمّد بن النعمان بن منصور التميمي القاضي) (ت 365ه / 975 م) الذي لم يطق البقاء في العراق، لذلك التحق معزّ الدولة الفاطمي(6) في مصر سنة 363 ه / 974 م، وبقيّ
ص: 234
هنالك إلى حين وفاته سنة 365 ه / 976 م . هكذا تشكّلت الحقبة الممتدّة من الغيبة الصغرى داخل العراق وخارجه، وصولاً إلى عصر الصدوق الذي يشكّل لنا الركيزة الثانية في الفكر الاثنا عشري خلال المرحلة القادمة.
إنّ الخطّ المحافظ الذي مثّله الكليني(1) وتلامذته وجد بوادر (تحرّرية) للخروج على ثوابته، سنترك لغيرنا البحث فيه وتتبّع مساره وصولاً إلى المشروع الأُصولي الاثنا عشري.
الحقبة الثانية : الشيخ الصدوق بين المحافظة والتجديد.
إنّ الشيخ الصدوق نتاج مدرسة كلامية - فقهية لها حضورها الرائع في تاريخ الفكر الاثنا عشري، وقبل أن نتحدّث عن دور الصدوق في هذا الميدان، لا بد أن نقف أوّلاً عند هذه المدرسة، لننتقل بعدها إلى الشخصية المدروسة، بعدّها مكملة لجهود الشيخ الكليني، على الرغم من اختلاف ظروف الشخصين والمدرستين.
أوّلاً : مدرسة قمّ الحديثية:
1 - ثبت في كتاب البلدان أن قمّ
مدينة افتتحها أبو موسى الاشعري سنة 23ه-/643م، ومصرّها طلحة بن الاخوص الاشعري في ايام الحجاج سنة 83ه-/702م، وصف اهلها بأنهم شيعة أمامية، والذي نقل التشيع اليها من الكوفة عبد اللّه بن سعد الاشعري(2).
2 - لقد اعتمد جلّ الذين تابعوا الأثر الاثنا عشري الذي وضع الكليني أساسه القويّ في الكافي على وفق المنطق (النقلي) ، النصّ المقدّس، والاعتماد على المأثور
ص: 235
من الحديث النبويّ الشريف وأخبار الأئمّة، ولم يجتمع الخطّ الإمامي إلى التفسير (بالرأي) إلاّ في قرون لاحقة على زمن الغيبة.
ومثل ذلك وجدناه في عصر الأئمّة(1) ماثلاً في تفسيرات:
أ . سعيد بن جبير التابعي (ت 64 ه- / 683 م).
ب . إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي (ت 127 ه- / 744 م).
ج . جابر بن يزيد الجعفي (ت 127 ه- / 744 م)، وغيرهم. فما توجّهات هذه المدرسة؟
عند العودة إلى اتّجاهات مدرسة قمّ الحديثية، نجد التوجّه المحافظ على تتبّع أثر الأئمّة، من قبل رجال هذه المدرسة، ولاسيما في حقبة الغيبة الصغرى وعصر الشيخ الكليني، حتّى عُدّ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار الأعرج (ت 290 ه- / 919 م) هو المؤّس الحقيقي لفقه الإمامية في إيران عموماً، وفي قمّ على وجه الخصوص، وكتابه بصائر الدرجات في علوم آل محمّد خير دليل على منهج مدرسة قمّ ؛ لأنّه ينطوي على مجموعة للحديث ربّما سبق بها الكليني في الكافي(2).
عُدتّ مدرسة قمّ بمثابة المركز السلفي العامّ في الفكر الاثني عشري في هذه الفترة بعد أن وصلت بنشاط رجالها إلى الذروة، وهم يمثّلون نقاء العقيدة المستمدّة من نبعها الصافي الرقراق، رافضين الأفكار المتأخّرة، كالغلوّ والغلاة، حتّى ذكر لنا النجاشي في رجاله جملة مَن طردهم القمّيون من قمّ لغلوّهم(3).
إلى جانب تنويهنا في الصفحات السابقة عن موقف القمّيين من الحلاّج ودعاواه في سفارته للمهدي عليه السلام (4)، وكان موقف المدرسة في مسألة نفي السهو على
ص: 236
النبيّ صلى الله عليه و آله (1) معروفاً من القائلين به.
وبعد تعداد كتب الرجال لعشرات من القمّيين نقف عند أشهرهم ممّن شكّل مورداً للصدوق:
1 - أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار الأعرج (السابق) الذي عدّ المؤّس الحقيقي - كما قلنا - وأكثر من ذلك، فلقد زار العراق، ولقيّ السفراء، والشيخ الكليني وسواهما(2).
2 - شيخ الطائفة بقمّ؛ أبو الحسن علي بن الحسن بن بابويه القمّي (ت 329 ه- / 940 م) والد الصدوق، الذي عُدّ أوّل من ابتكر طرح الأسانيد عن الأخبار، وجمع بين النظائر وأتى بالخبر مع قرينته، ولا سيّما في رسالته إلى ابنه الصدوق (ت 381 ه- / 991 م).
وجميع من تأخّر عنه، يحمد طريقته بها، ويعوّل عليها في مسائل لا يجد النصّ عليها؛ لثقته وأمانته، وموضوعيته في الدين والعلم(3).
كما اجتمع ابن بابويه في العراق مع السفير الثالث، أبي القاسم الحسين بن روح، وسأله مسائل ثمّ كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر المتوفّى سنة تناثر النجوم(4).
ولتلك الصلة أهمّية كبيرة لمن يتّبع سلاسل الاتّصال المعرفي بين مدرسة قمّ الحديثية، ومدرستي بغداد والكوفة، مع مركز الإشعاع العلمي المنطلق من (سامراء) بواسطة ثقاة عدول، حافظوا على العلاقة بين الإمام الثاني عشر في غيبته الصغرى، ورجال الإمامية الاثني عشرية، حتّى فاضت بهم كتب المؤرّخين والرجاليين والمتكلّمين(5).
ص: 237
ثانياً : الشيخ الصدوق (381 ه- / 991 م) شيخ الطائفة(1) في خراسان، ورد بغداد سنة 355 ه- / 965 م.
وكان له فضل التأثير في توجيه سياسة البويهيين حين صحب ركن الدولة بن بويه الذي استعان بتعاليمه في الإمامة على تدبير السياسة(2)، ولعلّه ذات الدور الذي سوف يمارسه العلاّمة الحلّي في البلاط الإيلخاني بعد أربعة قرون مع خدابنده(3)، ويقاربه دور الشيخ علي بن العالي الكركي، زمن طهماسب الصفوي بعد خمسة قرون(4).
وصفته الكتب الرجالية، بأنّه كان بصيراً بالأخبار، ناقداً لها، عالماً بالرجال(5).
كان رئيساً للمحدّثين، الذين زاد عددهم في زمن أبيه (المتوفّى عام 329 ه- / 940 م)، وفي مدينة قمّ بالذات، عن مئتي ألف محدّث، حتّى استفاد من علمه كلّ من لا يحضره الفقيه(6).
امتدحه المحافظون اللاحقون؛ لالتزامه بالأثر، ولا سيّما ابن طاووس(7) ومحمّد أمين الإسترآبادي، الذي نقل عن مقدّمة كتاب من لا يحضره الفقيه ما يلي :
هو على غرار من لا يحضره الطبيب لمحمّد بن زكريا الرازي وهو في الفقه والحلال
والحرام والشرائع والاحكام .
وأردف قائلاً :
ص: 238
وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل واليها المرجع(1).
فنحن نتكلّم إذاً عن الصدوق الذي أنجز المرجع الثاني للاثني عشرية السلفية (كتاب من لا يحضره الفقيه)، لضرورات أملتها عليه طبيعة المرحلة اللاحقة لانقضاء فترة الغيبة الصغرى، وفي أجواء سياسية إيجابية، ولا سيّما زمن الوزير البويهي ركن الدولة(2).
إنّ منهجية كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق الذي أكمل مشروع الكليني المحافظ ممّا دفع بالسيّد نعمة اللّه الجزائري (ت 1112 ه- / 1700 م) إلى القول :
إنّ الكليني والصدوق، صرّحا بصحّة ما أودعاه في كتابيهما من الأخبار (المعصومية)، وذلك أنّ الصحيح عند القدماء ما ثبتت صحّته وأفاد العلم(3).
وإن علّق على كتابه هذا الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري (ت 933 ه- / 1526 م) بتأليف سمّاه : التنبيه على غرائب من لا يحضره الفقيه(4)، ولاسيّما فيما يتعلّق بالإسهاء(5) على النبي صلى الله عليه و آله ، فلقد كان الصدوق حرباً على الغلاة ممّن حاول رفع الأئمّة عليهم السلام فوق إنسانيتهم الكاملة(6)، لذلك جعل النصوص التي تتحدّث عن ذلك السهو، إسهاء من اللّه للنبيّ صلى الله عليه و آله (7)، وإن صوّب له كلّ من الشيخ المفيد والشريف المرتضى(8) وصولاً إلى
ص: 239
الشيخ الطوسي (ت 460 ه- / 1067 ه) الذي اكتملت بكتابيه، التهذيب والاستبصار الكتب الأربعة للاثني عشرية في الأخبار المعصومية.
إنّ سلفية الصدوق - التي هي حلقة في سلسلة - الفكر الاثني عشري، كشفت عن نفسها في التمسّك بالظاهر من النصوص ممّا لا يستبعد معه بحث هذا المفكّر لإشكالية الآيات التي تتحدّث في ظاهرها عن صغائر. نعم، فالصدوق يقول بجواز الصغيرة على الأنبياء، في ضوء تأويل ظاهر القرآن، وبخاصّة مايتعلّق منها بعصمة آدم عليه السلام التي كانت (صغيرته) في الجنّة، قبل النبوّة على الأرض، قائلاً :
وكان ذلك من آدم قبل النبوّة، ولم يكن ذلك بذنبٍ كبير يستحقّ به دخول النار، وإنّما كان من الصغائر الموهوبه التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم، فلمّا اجتباه اللّه وجعله نبيّاً كان معصوماً، لا بذنب صغيرة ولا كبيرة(1).
وليس ذلك بجديد على الفكر الاثني عشري المحافظ، فلقد تحدّث قبل الصدوق الكليني، لكنّ الصدوق حاول في هذا المبحث الاعتماد على أخبار الرضا عليه السلام لصرف
الكثير من الآيات عن ظاهرها الذي يدلّ على وقوع (معصية صغيرة) إلى حيث التنزيه، الذي يمرّ من النبوّة إلى الولاية نقول : إنّ موقف الصدوق هذا وقبله إشارة الكليني حول النظر إلى ظاهر الآيات المخصوصة بهذا الموضوع، لم يمرّ دون نقد من قبل الاتّجاه الاجتهادي (العقلي) تحت دعاوى أنّ الصدوق قد عوّل على أخبار آحاد أو أخبار غير موثوقة(2)، بخلاف ما دأب عليه سلفية الاثني عشرية من الوثوق بما ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه(3) فالصدوق من قدماء الأخبارية علماً ومنهجاً، كما كان الكليني من قبل(4)، ما دام مصدره يعود إلى النبوّة . «وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ
ص: 240
يُوحَى»(1)، وبذلك استقامت المسيرة المعصومية للفكر الاثني عشري على هاتين الركيزتين، ممثّلة بكتابيهما إلى جانب الكتب اللاحقة، فهل هناك ثمّة فضل للكليني بعد أحد عشر قرناً أكثر من ذلك؟
تلك سياحة فكرية ذات ثوابت جغرافية وتاريخية وعقيدية، معروفة الزمان والأشخاص والأدوار، وقعت لشخصيّتين كبيرتين، في مسيرة الفكر الاثني عشري، وأقصد بهما الكليني والصدوق، في حقبة هي الأخطر بين جميع الحقب؛ لتعلّقها بما قبل الغيبة وما بعدها، وما انبنى على هذه الغيبة من تداعيات سياسية وكلامية وفلسفية، رافقت الفكر الاثنا عشري بخاصّة، والفكر الإسلامي بعامّة، والفكر الإنساني بوجهٍ أعمّ، وما زالت وسوف تبقى إلى ما شاء اللّه، وأعني بها مسألة (الولاية) التي ستصاحب الناس إلى حين يأذن اللّه بأمره ليعيد الحقّ إلى نصابه ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن مُلئت ظلماً وجوراً.
هذا هو ملخّص المشروع العقيدي والفلسفي الذي ندب له السلف الاثنا عشري، الذي كان حلقة وصل بين الأئمّة عليهم السلام وأتباعهم، وبين عصر الأئمّة والعصور اللاحقة!
فهل هناك أهمّية في الأدوار كتلك التي اطّلع بها رجال الاثني عشرية في الكوفة وبغداد وقم وسواها من المراكز الاثني عشرية، تكمل مسيرة الفكر الإمامي في دولة طبرستان العلوية، وزيدية اليمن، وفاطمية الشمال الأفريقي، ومصر، وصولاً إلى الانفتاح السياسي في بغداد في ظلّ ركن الدولة البويهي، إنّه جهد مشترك تجمع عليه العقلية الإمامية لتختزل في الخطّ الاثني عشري (المعتدل)، وها نحن نستذكره بعد أحد عشر قرناً على وفاة الكليني وعلى حافّاته وفاة ابن بابويه القمّي وولده الصدوق، فعسانا وفّقنا في مشروعنا هذا، ومن اللّه التوفيق والسداد.
ص: 241
ص: 242
لا يختلف اثنان في أنّ الإنسان خُلق كائنا مفكّرا عاقلاً يتطلّع إلى اكتشاف المجهول النوعي والمجهول الشخصي بدوافع غريزية فطرية ، حتّى تحوّل توصيف جهده الاكتشافي من تطلّع فطري إلى واجب ديني أو واجب فلسفي ، عند الكثير من المذاهب الاجتماعية الكبرى والأديان السماوية العظمى .
ولقد نشأت من جراء هذا التوافر الفطري والفكري والقانوني نظرية فكرية تعنى بالمعرفة من حيث ضرورتها وغائياتها ومرجعياتها ومسالكها وقضاياها ، وتعدّ نظرية المعرفة من بين القضايا الأكثر حيوية في الفكر الإسلامي ، ولا نبالغ أذا قلنا إنّها قسيم العلوم الأساسية كالكلام والفلسفة ، وإنّ أيّ نقاش فكرى لن يكون ذا قيمة ما لم تحسم المعرفة الإنسانية منحاها واتّجاهاتها وقيمها ، وهي أبرز أركان نظرية المعرفة عامّة .
ورغم أهمّية مثل هذه التوصيفات ، لم تجد نظرية المعرفة عناية فائقة ومستقلّة قي أبحاثنا الإسلامية بعامّة ، وفي الأبحاث الحديثية بخاصّة ، لجهة أنّ علم الرواية ينأي بنفسه عن العلوم العقلية والفلسفية .
ص: 243
والحقّ أنّ المعين الذي تستقي منه الإلهيّات والفلسفة والحكمة وعلم الكلام الإسلامي قديمه وجديده ، هو إشراقات النصّ المعجز (القرآن الكريم) ، وتجلّيات الحديث النبويّ ، والرواية عن الأئمّة المعصومين صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين ، كما أنّ هذه الأُصول المطهّرة تقع أساساً للتفكير العلمي عند المسلمين .
لذلك صار من الضروري طرح نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي ، ولكن من منابعها الرئيسة ، وهي القرآن ومرويات الأئمّة ، التي يعدّ ثقة الإسلام الكليني من أوائل من جمعها وبوّبها وصنّفها طبقا لمعيار موضوعي ، ولأنّ فكر الشيعة الإمامية مستند إلى ما صدر عن الإئمّة من آل البيت عليهم السلام ، فإنّه يعبّر عن مقاربة أكثر يقينية عن رؤية الإسلام كمنظومة فكرية كبرى .
لذلك صار إمكان التعرّف على نظرية المعرفة من خلال مرويات الكليني هي هدف هذا البحث وفرضيته العامّة .
ومن الواضح أنّ العلاقة بين الدين والمعرفة علاقة جدلية ، فالدين الصحيح هو الذي ترجّحه أدوات المعرفة اليقينية من بين الأديان الكبرى في العالم ، فالتقليد في الأُصول الاعتقادية إحدى عيوب التديّن ، وهذه إحدى أبرز قواعد المنطق الديني بل المنطق الفكري بعامّة .
هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى فإنّه حينما يُراد من الدين أن يحقّق للناس تنمية حضارية ، فسيتحوّل الدين إلى دافع لاتّساع المعرفة ، فهو يترجّح من خلال المعرفة ، وهو في ذات الوقت يؤسّس لمعرفة ، إلى جانب أنّ لكلّ دين رؤية كونية ، ومعيناً للإجابة عن الأسئلة الأزلية ، فلا بدّ للدين من أن يجيب عن تساؤلات الإنسان الاُولى والبديهية ، وينقل العقل الإنساني من المجهول إلى المعلوم ، لا سيّما في قضايا أو مضامين تلك الأسئلة الأساسية عن الوجود والموجد ، والغاية من الوجود ، ودور الإنسان ومدى حرّيته في الفعل الكوني ، وحجم مسؤوليته إزاء أفعاله ، وصلته بالطبيعة ، والدور التاريخي له ، ومعنى الزمن الذي يمارسه .
ص: 244
لقد عرّف الدارسون - على كثرتهم - المعرفة تعريفات كثيرة ، أبرزها : «إنّ المعرفة : ثمرة التقابل بين ذاتٍ مدركة وموضوع مدرك» ، وتطلق نظرية المعرفة (egdelwonk fo yroeht) على البحث في إمكان تحصيل المعرفة البشرية ، ومصادر المعرفة ، والطرق الموصلة إليها ، والغاية منها .
ويعدّ موضوع المعرفة قديما قدم الفكر البشري ، فقد نُقل عن أفلاطون أنّ المعرفة : «هي اعتقاد صادق مسوغ» ، أي أنّ له ما يسوغه أو يقوم عليه برهان(1) .
وقد ظهر موضوع المعرفة عند الفلاسفة المسلمين ومتكلّميهم(2) ، وانتقل إلى مفكّري الغرب ، فكان جون لوك(1690 م) يعالجه في مبحث الفهم الإنساني في كتابه مقالة في التفكيرالإنساني(3) ، ورَبَطه «كانت» (1724 - 1804) بالوجود ، لعبارته المشهورة: «أنا أُفكّر ، إذن أنا موجود»(4) .
وإزاء البحث في إمكان الحصول على المعرفة ، نواجه مشكلة الشكّ وضرورة التفريق بين المعرفة الأوّلية (قبل التجربة) ، والمعرفة المكتسبة أي المعرفة البعدية .
وتُدرس الشروط التي تجعل الأحكام على الأشياء والأفكار ممكنة ، وتسوغ وصفها بالصدق ، كما تُبحث في الأدوات التي تمكّن من العلم وتحدّد مسالك المعرفة ومنابعها .
وقد ظهر متأخّرا مصطلح الابستمولوجيا(ygolometsipe) ، ويترجم حرفياً نظرية العلم أو فلسفة العلوم ، كما يقول «لالاند» ، أي الدراسة النقدية لمبادئ العلوم وفروضها ونتائجها(5) .
ص: 245
ومنذ القدم انقسم المفكّرون إلى أصحاب النزعة التوكيدية الذاهبين إلى أنّ العقل يمكن أن يوصل إلى اليقين ، وأصحاب النزعة الشكلية الذين يشكّون في إمكان تحصيل الحقيقة العلمية ، وقد حوّل المتأخّرون الشكّ إلى منهج ، وهو (خطوة على طريق البحث عن المعرفة الصحيحة) .
وانقسموا من حيثية ثانية إلى أربعة شرائح : العقليّون الذاهبون إلى أنّ العقل يستقلّ بالإدراك دون مقدّمات تجريبية ، وتجريبيون ذاهبون إلى أنّ الخبرة الحسّية هي مصدر المعرفة ، وحدسيون قائلون بوجود ملكة أُخرى للمعرفة (التجربة الوجدانية) سمّوها الحدس (noitiutni) ، وبرجماتيون (msitamgarp) يذهبون إلى أنّ صحّة الفكر تعتمد على ما يؤدّي إليه من نتائج عملية ناجحة .
ممّا تقدّم يتبيّن أنّنا نريد أن نحدّد ملامح نظرية المعرفة بالاستناد إلى مرجعية معيارية مخزونة في كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني ، التي تنقل الرواية عن آل البيت عليهم السلام ، ليصحّ القول إنّها نظرية المعرفة عند الإمامية .
إذا كان البخاري قد افتتح جامعه بحديث : «إنّما الأعمال بالنيّات» ، فإنّ الكليني ابتدأ كتابه بحديث (خلق العقل) ، فقد روى عن الباقر عليهم السلام إنّ العقل هو المخاطب بالتكاليف، وعليه المدار في الجزاء، وجاء فيه :
أمَا إنّي إيّاك آمر وإيّاك أنهى، وإياك أُعاقب وإياك أُثيب(1) .
وعن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الإمام الباقر عليهم السلام ، قال :
إنّما يُداقّ اللّه العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا(2) .
ص: 246
وطبقاً لنصّ حديث الأصبغ بن نباتة: «إنّ الحياء والدين أُمِرا أن يكونا مع العقل»(1)، بما يؤسّس إلى أنّ النظم المعرفية الأخلاقية الكشفية أو المعرفة عن طريق الوحي ، لا يتضادّان مع العقل المجرّد(2) ، وتصحّ مرويات الكافي:
إنّ اللّه لم يبعث نبيّا ولا رسولاً حتّى يستكمل رجحان العقل ، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أُمّته(3) .
ومنه نعلم أنّ أُنموذج المعلّم أو الحكيم الملهم أو العقل المدبّر، مفاهيم تصلح مقدّمات تأسيسية لمصطلح العصمة في الفكر الديني للأنبياء ، وربّما الأساس الفلسفي لمفهوم العصمة عند الشيعة الإمامية ، أي أنّها استكمال المقدرة دائما على فعل الأصلح.
ومن هنا ، يمكن استخلاص هذا الجزء من نظرية المعرفة، وأبرزها :
1 - لا تقاطع فعلي بين العقل والحدس والوحي ، فهي طرق موصلة إلى العلم ، سواء في مجال الظنّ المعتبر أو اليقين القطعي .
2 - إنّ إقرار العقل كمقدّمة للاعتقاد واعتباره مناطاً للتكليف (المسؤولية - الحرّية) ، يعطيه رتبة متقدّمة على المسائل الأُخرى .
3 - إنّ كمال العقل تفسير مقبول لماهية العصمة ، وهو المؤهِّل الربّاني للقادة الإلهيّين بما يجعلهم القادرين على اكتشاف الأصلح دائما وفعله ، واعتبار ذلك مقدّمة للمعرفة لطريقة اتّباع الأُنموذج .
ومن المهمّ جدّا أن نشير إلى أنّ حديث الإمام الكاظم عليه السلام فيما يرويه هشام بن الحكم وحده، يصلح إذا قمنا بتحليل مضمونه الفكري، ويعدّ المُسوّغ الروائي في تفضيل الرؤية الإسلامية للعقل. فهو من جهة يقرّر الحقائق ويستند إلى آيات الكتاب
ص: 247
العزيز ، ويجعل البرهان والبيان والوجدان ثلاثة مسالك للوصول إلى الحقيقة(1)، فهو عليه السلام يقول :
يا هشام، إنّ اللّه تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ، ونصر النبيّين بالبيان، ودلّهم على ربوبيته بالأدلّة(2) .
ثمّ ساق معها الإمام عليه السلام الآيتين 163 و 164 من سورة البقرة ، وقد جعل الإمام عليه السلام العقل بمصاف الرسل، فجعله الحجّة الباطنة ، أي قسيم الحجّة الظاهرة وهي الأنبياء والرسل والمعجزات .
من أوائل ما يطرحه العقل من أسئلة أساسية : هل المعرفة متاحة؟ وهل بإمكان العقل البشري حيازة المعرفة ؟ وهل يمكن فهم التحوّلات من المجهول إلى المعلوم . . . ؟ هذه المباحث يجمعها عنوان (إمكان المعرفة) .
بدءا لابدّ من التفريق بين الإمكان الكلّي والإمكان النسبي ، فالإمكان الكلّي ؛ أي التصوّر بأنّ الإنسان بإمكانه أن يحيط بالعلم بما يمكنه التوصّل إلى الحقيقية المطلقة .
والإمكان النسبي ؛ هو قدرة الإنسان على إدراك ما يمكن إدراكه بحسب القدرات والمستوى المتاح من المعرفة مع اعتبار قيد الزمان والمكان ، وبالعبور السريع على هذا الخلاف - لعدم حاجة البحث له - نقول : إنّ الإمكان بالمعنى الأعمّ هو رأي العلماء جميعا .
فطالما أنّ المعرفة ممكنة ، فهل الإنسان المسلم مخيّر بين اكتسابها ، أو عدم اكتساب المعرفة من جهة الحكم التكليفي ؟ وبالمتابعة نجد أنّ موقف الإسلام ، بل موقف مذهب أهل البيت عليهم السلام ، أنّ العلم فرض ، والفرض إمّا فرض اجتماعي (يأخذ
ص: 248
صفة كفائية) ، أو فرض على الأفراد بحيث الكلّ مطالبون باكتساب المعرفة ، (بما يُعرف بالوجوب العيني) ، ومن اعتبار قاعدة أن «لا تكليف إلاّ بمستطاع» ، فإنّ مجرّد التكليف يقتضي القول بأنّ المعرفة متاحة ، وأنّ العقل البشري يمكنه حيازتها وفهم تحوّلاتها .
فالإمام الصادق عليه السلام يروي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»(1) ، وعنه عليه السلام : «طلب العلم فريضة» ، والحديثان ليس فيهما دلالة على الوجوب الكفائي ، بل الدلالة ناطقة بالأعمّ ، لكن بالاستعانة بما رواه يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه أنّ الإمام الكاظم عليه السلام سُئل : «هل يَسَع الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه ؟ قال عليه السلام : لا » ، فإنّ ذلك يكشف وجوب المتابعة، بل وجوب المقدّمة تبعاً لذيّها .
إذن، فعدم السعة (الحظر) يرد على الإعراض عن معرفة نحتاجها أفرادا ، أو مجتمعات، فلابدّ من اكتسابها ، لذلك يمكن القول إنّ ما يحتاجه الفرد من أحكام فقهية وأحكام التعاملات الخاصّة بمهنته وأحكام العلاقة بينه وبين الدولة حقوقه وواجباته، كلّها في دائرة الفرض على أضيق نطاق ، ولأجله حكم الفقهاء أنّ ما يلزم أن يُعرف من فقه التكليف يعدّ من جنس الواجب .
وقد ألحقت به قضية التفقّه بالدين ، لتضيّق النطاق (نطاق طلب المعرفة) من مجال المعرفة العامّة إلى المعرفة الدينية بالمعنى الأخصّ ، والدليل على ذلك أنّ الرواية ربطت بين العلم وبين استخدام العلم، بحيث اعتُبر جهله مضرّا وعلمه نافعا(2)، فيرد الحديث :
إنّ العلم آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سُنّة قائمة ، وما خلاهنّ فهو فضل .
ولعلّك تفهم من مصطلح «آية محكمة» بناءً على أنّ لفظ آية يرد بمعنى البرهان
ص: 249
والدليل ويراد به (القوانين التكوينية)، ويُفهم من «فريضة عادلة» مجموعة الأحكام القانونية المنظّمة للحياة الاجتماعية ، ويُفهم من «سنّة قائمة» أي المندوبات التحسينية التي تيسّر الحياة، فإنّ هذه المتطلّبات الثلاثة هي نقطة الشروع فيما يجب أن يعرف ، ولأجل الوصول إلى المعرفة فإنّ حثّ الرواية على السؤال كاشف عن أنّ المقدّمة تأخذ حكم ما بعدها، فقد قال أبو عبد اللّه عليه السلام لحمران بن أعين : «إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون»(1)، ثمّ يؤسّس بقوله : «لا يسع الناس حتّى يسألو»(2) درءاً للهلاك .
وتجد في خزانة الحكمة (المرويات عن أهل البيت صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين) أخبارا أنّ اللّه تعالى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم(3) . وهذا تكليف للعلماء ؛ لقوله عليه السلام «زكاة العلم أن تعلّمه عباد اللّه . . .» .
ممّا تقدّم يتقرّر :
1 - إنّ المعرفة في الأصل التكويني الفطري فرصة متاحة للإنسان من حيث ماهية المعرفة ، ومن حيث القابلية البشرية على حيازة المعرفة .
2 - إنّ المعرفة نسبية بالقدر الذي تحقّقه الاستطاعة الإنسانية ، فيما عدا المعصوم عند الشيعة الإمامية .
3 - إنّ العالِم مكلّف بنشر علمه ، واستخدامه للتقدّم الإنساني .
4 - إنّ الإنسان مكلّف بأن يتعلّم الحدّ الأدنى ممّا يحتاجه من العلم ، ومعيار (الحاجة) معيار حركي نامي، ويتّسع باتّساع الحاجة .
5 - إنّ النصوص تربط العلم بالمصلحة (النفع - الضرر) ، ولأنّ الحياة الإنسانية مرتبطة تمام الارتباط بالمصالح (النفع) والمفاسد (الضرر)، فإنّ المعرفة للحياة ضرورية ضرورة قصوى، وذات صلة جوهرية بوجود الإنسان . فضلاً عمّا يلحق
ص: 250
بالوجود الإنساني من أفكار وسلوكيات ، وحاجيات وتحسينات .
في الحديث عن غاية المعرفة هناك مسالك واتّجاهات ، منها : الغاية الذاتية على مسلك المعرفة لأجل المعرفة ، الغاية المثالية ، الغاية التعدّدية الخالصة ، الغاية البرجماتية .
فما هي الغاية في فكر الشيعة الإمامية ؟
تهدف المعرفة في التصوّر الإسلامي (خطّ أهل البيت عليهم السلام) إلى تحقيق نوعين من الغايات ، الغايات الوسائلية ، والغاية النهائية .
فالغايات الوسائلية هي :
1 - إنّ المعرفة إحدى أهمّ الخصائص التي تسهم في تكامل الإنسان ، وبذلك تحقّق أحد أهداف الشريعة (الوحي) الذي يهدف إلى أن يرتفع بالإنسان من المستويات الأدنى إلى مستوى التكامل .
يقول الإمام الكاظم عليه السلام :
يا هشام ، ما بعث اللّه أنبياءه ورسله إلى عباده إلاّ ليعقلوا عن اللّه، فأحسنهم استجابةً أحسنهم معرفةً ، وأكملهم عقلاً أرفعهم درجةً(1) .
2 - إنّ الإسلام رسم العلاقة بين الإنسان المستخلف في الأرض وبين الطبيعة على أنّها علاقة تضامن وتكامل ، فاللّه تعالى سخّر الطبيعة وأوجد ممكناتها لصالح الإنسان ، وهو عزّ وجلّ زوّد الإنسان بقوّة العمل وبالمعرفة ، للتعامل من خلالهما مع الطبيعة لخلق مستلزمات الحياة الكريمة التي تؤدّى فيها عبادة اللّه أداءً ميسّرا .
فقد روى الصادق عن جدّه أمير المؤمنين عليهماالسلام :
إنّ التفكّر يدعو إلى البرّ والعمل به(2) .
ص: 251
أمّا الغاية النهائية ؛ فمن غاية كمال الإنسان وسموّ المرتبة التي يصل إليها وفق حياة كريمة يعيشها، يتحقّق مفهوم عبادة اللّه، وهي غاية الخلق ونهاية مقاصد الخليقة والتكوين؛ لقوله تعالى : «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ»(1) .
بينما غاية المعرفة في التصوّر الغربي الحديث أنّ المعرفة وسيلة لتحقيق مفهوم القوّة والغلبة ، بمعزل عن القيم الموجّهة لهذه القوّة وقهر الطبيعة، وكأنّ العلاقة الموسومة بين الإنسان والطبيعة علاقة صراع ، وتتأسّس غائيات المعرفة في الفكر الغربي على تسيّد الإنسان على الكون ، حيث تهدف إلى جعل مركزية الإنسان محورا للفعاليات الطبيعية والاجتماعية، وهذا النمط من التصوّر يسبّب مأزقا في الذات الحضارية للتصوّر الغربي .
في حين أنّ التصوّر الإسلامي يقرّر أنّ اللّه هو سيّد الكون، والإنسان خليفة ذلك السيّد الأوحد الأحد المطلق ، فالإنسان ليس سيّد الكون ، إنّما السيّد في الكون هو اللّه، والمنظومة التوحيدية تقوم على وضوح المركز القانوني لكلّ من اللّه والإنسان ، فاللّه الموحي والمفيض للمعرفة ، والإنسان هو الذي يتلقّى الوحي أو يسترشد به .
فقد روى الإمام الكاظم عن جدّه أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليهما قوله :
ما عُبِد اللّه بشيءٍ أفضل من العقل(2) .
ومنه يُستفاد أنّ استخدام العقلانية ليس في مجال ضبط المعرفيات فقط ، إنّما في عموم التعامل مع الأشياء ، والأفكار تعدّ عبادة ثمينة ونفيسة .
يعدّ هذا المفصل من أكثر مفاصل نظرية المعرفة تعقيداً ؛ ذلك لأنّ ماهية المعرفة ومسالكها تحدّدها مصادرها ومرجعياتها، فكيف نحدّد مرجعية المعرفة في التصوّر
ص: 252
الإسلامي استناداً إلى مرويات أهل البيت عليهم السلام في الكافي .
لقد تقدّم أنّ نزاعا قديما حول مراجع المعرفة ومصادرها . . . هل العقل أو الحسّ (الملاحظة والتجربة)، أم الحدس والكشف ، وقد خضع هذا النزاع لمقتضى تقدّم المناهج العلمية وتطوّر نظريات نقد المعرفة، فسلّم جمعٌ من العلماء بأنّ القدر المتيقّن من المعقولات تعمل في مجال المعرفة الأوّلية التي تسبق التجربة ، وسلّم العقليّون أنّ المعارف التي يتمّ اكتسابها عن طريق التجربة (معرفة بعدية)، وهي الأُخرى تحتاج للعقل لكي يطبّق عليها الاستقراء والقياس.
لكنّ الموقف النقدي الراجح نظرية حتمية المرجعية الواحدة للمعرفة(1) ، كما هو اختيار مرحلة قرون النهضة الأورپّية (البيكونية) التي حصرت المعرفة بالتجربة(2) ، ويرفض ما ظهر في حضارة الهند وما بنت عليه المسيحية ما سُمّي بمفهوم الاعتقاد [htiaf]، (وهو فعل أو عزم يعقد المرء النيّة على أن يقبله كشيء صادق) .
أمّا منهج العترة من آل البيت عليهم السلام في مراجع المعرفة ، فإنّهم يصرّون أنّ أوّل المرجعيات وأكثرها اتّساعا وحي اللّه تعالى للبشر، ثمّ إنارة المعصومين ، ثمّ الحجّة الباطنة (العقل) ، ولا مانع من أن تكون الملاحظة والتجريب رافدا من روافد المعرفة ، ومن نعم اللّه علينا أنّ العلم مرتبط بمعيار مهمّ، وهو ألاّ يصطدم الفكر مع حقيقة نقلية ، أو قاعدة عقلية قاطعة .
والوحي في التوصيف الإسلامي مرجعا معرفيا يتميّز عن البقية من مراجع أو مصادر المعرفة بأنّه يحتوى على إدراك الحقيقة المطلقة، أي أنّه يعلم الأشياء على حقيقتها، فإنّه «لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنم بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِى»(3)، وإنّه يقدّم معارف متنوّعة ، فهو قادر على أن يقدّم المعرفة منفردا عن كلّ المصادر . وأخيرا ، فإنّه يحوى الأخبار
ص: 253
عن الغيب أو الشهود ، وإدراك جوهر القوانين الكونية والسنن الحاكمة على الوجود برمته .
إنّنا هنا مضطرّون لإثارة قضية حصل فيها التباس تاريخي ، وهي ظهور موجة حسّية في مطلع القرن الحادي عشر الهجري على يد الإسترآبادي ، فقد قلّل من دور المنطق المعياري ، وتوقّف على مداليل الأخبار المتغيّرة بتغيّر العقل الذي يتعاطاها، فضلاً عن معايير صحّة السند ومتانة المضمون ، لكنّ الإسترآبادي يقطع بصحّتهما معاً قبل تطرّق الاحتمال إلى البحث .
إنّ اتّهام التفكير الأخباري بأنّه يتبنّى اتّجاهاً حسّياً في المعرفة، أمر يحتاج إلى وقفة ؛ ذلك لأنّهم يعتقدون أنّ الإنسان مزوّد بمعرفة إلهامية نابعة من صميمه ، ممّا نتج
عنها معرفة ذات طابع إشرافي لم تُسبق بمعرفة قبلية ، إنّها من صنع اللّه . لذلك يقول الإسترآبادي :
إنّ التصديقات الصادقة فائضة على القلوب من اللّه تعالى بلا واسطة . . .(1) .
وينتقد عدد من الباحثين ، أنّ هذا التفكير يستبطن تناقضاً، كونه قد شجب العقل من ناحية ليخلو ميدان التشريع والفقه للبيان الشرعي، وظلّ متمسّكاً به لإثبات الصانع(2) .
عن أبن الطيّار، عن الصادق عليه السلام ، قال :
إنّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم وعرّفهم(3) .
عن محمّد بن حكيم، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المعرفة . . . مِن صنع مَن هي ؟ قال عليه السلام : مِن صنع اللّه ، ليس للعباد فيها شيء .
ص: 254
وإذا كان القرآن الكريم هو الوحي الموحَى والنصّ الربّاني المدوّن، فإنّ المنهج العلوي يقرّر أنّه لا يكون حجّة إلاّ بقيّم ، وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله هو مبلّغه والقيّم على تأويله؛ لأنّه سيّد الراسخين في العلم ، وأنّ عليّا عليه السلام - كما روى الصادق عليه السلام - «كان قسيم القرآن»(1) .
لذلك فإنّ (القدوة العالمة المجسّدة المعصومة المطاعة التي لا تتضارب مع نصٍّ موحى أو قاعدة عقلٍ قاطعة) هي المرجعية الثانية .
قال الصادق عليه السلام :
لمّا جمَعَ اللّه لإبراهيم أن اتّخذه عبدا قبل النبوّة، ونبيّا قبل الرسالة ، ورسولاً قبل أن يتّخذه خليلاً، وخليلاً قبل أن يجعله إماما . . . فلمّا جمع ذلك كلّه قال: «قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»(2) .(3)
وقد أوجز الإمام الباقر عليه السلام في خطابه لأبي حمزة، قال :
يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلاً . . . وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلاً(4) .
وجاء عن الصادق عليه السلام :
إنّه لا يسع الناس إلاّ معرفتنا، ولا يعذر الناس بجهالتنا(5) .
وجاء عن الصادِقَين عليهماالسلام :
نحن خزنة علم اللّه ، ونحن تراجمة وحيه(6) .
فإذا تحدّدت المرجعية الأساس (كتاب اللّه وكلام العصمة) من أنّهما ميزان العلم
ص: 255
ومعيار المعرفة ، فإنّ العقل هو الوعاء الذي يتلقّى عنهما، ولا يشقى بالشكّ، فإنّ اليقين الإجمالي حاصل لا محالة، ذلك الوصف الربّاني للحقيقة بالصدق المطلق المؤيّد بالدليل الأزلي والبرهان التامّ .
لذلك يمكننا القول : إنّ مرجعيات المعرفة في التصوّر الإسلامي يكمّل بعضها، لا تنافر فيها ولا قطيعة بين أجزائها ، فهناك تكامل بين الوجود والوحي، وبين النظر والملاحظة الدقيقة التجريبية ، وبين معرفة الشهود ومعرفة الغيب ، كلّ ذلك نابع من تجلّيات مبدأ التوحيد وأثره في إدراك وحدة الحقيقة .
في حين أنّ التجربة الحضارية الاُوربية تفصل - بل تتعارض في مرجعياتها - المعرفة الدينوية مع معرفة الغيب ، والمعرفة العقلية مع الحسّية .
لقد استخدم بيكون ديكارت كلمة منهج (dohtem) بمعناها الأوّلى، أي (قواعد للسلوك تفضي بلا هوادة إلى المزيد من المعرفة)، وبذلك يكمن ثمّة تناقض بين نقد بيكون للفلسفة العقلية، وبين اعتقاده بقوّة المنهج(1) .
واستخلاصاً من الأُصول المروية في الكافي يتّضح أنّ لمرجعيات المعرفة في التصوّر الإسلامي خصيصتين :
الاُولى : إنّها مركّبة ووظيفية من جهة، وإنّ لها تراتيبة قهرية من جهة أُخرى ، فكونها مركّبة فمن الوحي (التأمّل والنظر والعقل)، ومركّبة كذلك من عدم استبعاد الإلهام والحدس والكشف، وعدم التقليل من قيمة الملاحظة والتجربة في اكتشاف
المجهول .
ومع فصل مصدر المعرفة عن حجّيتها، فالحدس والإلهام والكشف من مصادر المعرفة ، وقد عرف الصوفية مسلك الحدس في اكتشاف الحقائق، فهم يرون أنّ
ص: 256
المعرفة العقلية وإن كانت أكثر رسوخا أذا ما قورنت بالمعرفة الحسّية ، إلاّ أنّ العقل له مجالاً محدوداً لا يتجاوزه ، وبيّن دور الحدس في مدى إيضاح اختراقه لما وراء العقل .
الثانية : مرتّبة تنازلياً من حيث إنّ الوحي هو الأساس والرؤية، ومنه تنتزع مشروعية المصادر المعرفية الأُخرى، ونلحظ أنّ الإيمان بالوحي لا يتمّ إلاّ بمقدّمات عقلية ومبرهنات نظرية . . . ودليل عقلي قطعي، سواء بواسطة المعجزة ليتحقّق الإيمان بالتوحيد وأُصول الرسالة، أو بالآليات الأُخرى العقلية للتعامل مع النصّ ، ثمّ آليات عقلية لما سكت عنه النصّ ، ثمّ إنّ الإقرار بنتائج التجربة الحدسية وعدم استبعاد (الكشف)، فإنّما لما له من مؤيّدات عقلية .
عن المعلّى بن خنيس قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه عزّ وجلّ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال(1) .
ورواية الصادق عن جدّه أمير المؤمنين عليهماالسلام أنّه قال :
ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق لكم ، إنّ فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينهم ، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون(2) .
ويلاحظ أنّ عشرات الأحاديث عن المعصومين أكّدت خصيصة الموافقة مع كتاب اللّه، وهي سمة من سمات الصحّة(3) .
إنّ قضية المرجعيات المركّبة من جهة ، والمترتّبة تراتبية خاصّة من جهة أُخرى ، تفكّك إشكالية يقينية المعرفة التي لا تزال دون حلّ في الغرب ، فهناك اختلاف في مدى المعرفة، فمنهم من يقول إنّ العقل يدرك المعرفة ويصل إلى اليقين، ومنهم
ص: 257
من يصرّ على أنّ المعرفة كلّها احتمالية، إلى جانب من يرى معرفة العالم مستحيلة .
وعليه ووفق التراتبية ، لا مجال لاعتماد مرجعية محدّدة أو محدودة للمعرفة في التصوّر الإسلامي .
وبذلك ندرك من جهة تاريخ الفكر عند المسلمين أنّ اعتبار أحد المصادر هو الأساس أو المسلك الرئيس ، وإغفال أهمّية ودور المصادر الأُخرى قد انتهى إلى التصدّع ، فلقد تصدّع الحدسيون الإسلاميون بالدرجة التي تصدّع المغالون في الاعتماد على العقلانية المجرّدة من تساند المسالك الأُخرى .
زخرت أحاديث الكافي بما يشكّل كتلة معرفية يكوّن مجموعها مسالك المعرفة، ومن تلك المسالك :
1 - إشاعة ثقافة السؤال والتساؤل : فبين النصّ والتساؤل مسلك للبيان . فقد ورد عن أصحاب الصادق عنه عليه السلام أنّه قال لحمران :
إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون(1) .
وورد عنه عليه السلام :
إنّ هذا العلم عليه قفل، ومفتاحه المسألة(2) .
وعنه عليه السلام قال :
لا يسع الناس حتّى يسألوا(3) .
2 - التعايش الدائم مع المعرفة ؛ وهو مسلك اعتبار هاجس المعرفة (قلق) دائم يسعى إليه الناس للاستزادة الدائمة، قال الإمام الباقر عليه السلام :
ص: 258
رحم اللّه عبدا أحيا العلم . قلت : وما إحياؤه ؟ قال عليه السلام : أن يُذاكر به(1) .
3 - تدرّج الإدراك ؛ وهو المسلك الذي يبدأ من السماع، فالاستماع، فالتفهّم، فالتدبّر . . . عن الصادق عليه السلام قال :
ألا لا خير في علمٍ ليس فيه تفهّم ، ألا لا خير في قراءةٍ ليس فيها تدبّر .
وعنه عليه السلام قال :
جاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول اللّه ، ما العلم ؟ قال : الإنصات ، قال : ثمّ ؟ قال صلى الله عليه و آله : الاستماع ، قال : ثمّ ؟ قال صلى الله عليه و آله : الحفظ ، قال : ثمّ ؟ قال صلى الله عليه و آله : العمل به ، قال : ثمّ ؟ قال صلى الله عليه و آله : نشره(2) .
4 - الحوار والمحاججة : وأنموذجها حديث الإمام الكاظم عليه السلام لهشام المارّ ذكره .
5 - الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة ؛ فقد روى الزهري عن الباقر عليه السلام هذا المسلك بنصّه، وأضاف :
وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه(3) .
وعن الصادق عليه السلام قوله :
لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه والتثبّت .
6 - التدوين : قال الصادق عليه السلام :
اكتبوا، فإنّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا(4) .
7 - التدقيق في أنّ القياس على إطلاقه لا ينتج عنه علما ، عن الصادق عليه السلام :
إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلاّ بعدا ، وإن دين اللّه لا يُصاب بالمقاييس .
وعنه عليه السلام قال :
ص: 259
إنّ السنّة لا تُقاس . . . يا أبان، إنّ السنّة إذا قيست محق الدين(1) .
8 - قانون التراجح المنهجي ؛ لا بدّ من حلّ حاسم لما يتشابه من الموارد، فالنظرية المعرفية الأكثر رصانة تبني عنواناتها الأوّلية أوّلاً ، ثمّ تعالج الطارئ بعنوان معرفي منهجي ثانوي ، نطلق عليه قانون الترجيح ، فعن عمر بن حنظلة (روايته التي تُسمّى مقبولة) وضع قانون الأرجحية المكوّن من :
أ . الأخذ بما حكم به الأعدل بين الفقيهين .
ب . الأخذ بما حكم به الأعدل والأفقه .
ج . الأخذ بما حكم به الأعدل والأفقه والأصدق والأورع .
د . الأخذ بما حظي بإجماع الأصحاب، ويُترك الشاذّ الذي ليس بمشهور .
ه- . فإذا كانا مشهورين رواهما الثقات، فيُلاحظ ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة ، وخالف العامّة(2) .
من خلال الرواية التي في سندها علي بن إبراهيم، وسماع سفيان بن عيينة عن الصادق عليه السلام ، قال :
وجدت علم الناس كلّه في أربع : أوّلها أن تعرف ربّك ، والثاني أن تعرف ما صنع بك ، والثالث أن تعرف ما أراد منك ، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دنياك(3) .
وممّا تقدّم يظهر أنّ الرواية أعلاه تؤكّد على أنّ من أهمّ قضايا المعرفة :
1 - الإلهيّات وقضايا الوجود .
2 - معرفة خلق اللّه ؛ أي دراسة علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية .
ص: 260
3 - معرفة المنظومة الحقوقية الأرفع التي تسهم في الاحتراز من أن يقع الناس في المشكلات والنزاعات ، وتعطي ذي حقّ حقّه .
4 - معرفة (الضارّ التكويني) والاجتماعي في العلوم الصرفة والإنسانية .
ممّا تقدّم يظهر أنّ مرويات الكليني في الكافي يمكن أن يُصاغ منها نظرية متقدّمة للمعرفة الإنسانية ، قابلة لكي تُعرض بوصفها (النظرية الإسلامية للمعرفة) .
ولعلّ هذا البحث يشكّل منطلقاً أوّلياً ، قد يفتح آفاقاً للاستزادة والاستقصاء لتكوين رؤية الإسلام الشيعي للمعرفة ، كإحدى أبرز قضايا الحوار في العالم المعاصر .
ص: 261
ص: 262
القرآن الكريم كما تصوّره
روايات أُصول الكافي
الشيخ محمّد علي التسخيري(1)
تتكوّن الشخصية الإنسانية من منظومة عقدية وتركيبة نفسية عاطفية، تؤدّي عند تصاعدها إلى تكوين إرادة وعزم يحرّك السلوك الواعي المحقّق للهدف .
ويعمل الإسلام بمقتضى واقعيته وفطريته على الاهتمام بكلّ هذه الأبعاد؛ ليضمن انسجام الإنسان مع السيرة الّتي تحقّق له أهداف خلقته كما أرادها اللّه سبحانه لها .
وهذا هو ما نشهده في النصوص القرآنية الكريمة والسنّة النبويّة الشريفة ، يقول الإمام عليه السلام :
العقول أئمّة الأفكار، والأفكار أئمّة القلوب، والقلوب أئمّة الحواسّ، والحواسّ أئمّة الأعضاء(2) .
ولمّا كانت الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام إنّما تعبّر عن القرآن والسنّة النبويّة أروع تعبير - كما يبدو من استعراضها أوّلاً ، ومن تأكيدهم بكلّ وضوح في أحاديثهم الثابتة عن ذلك(3) ثانياً - فإنّنا نجدهم عليهم السلام يركّزون على تلك الأبعاد وصياغتها الصياغة المطلوبة . وقد اخترنا أن نركّز في مقالنا على كتاب الكافي؛ باعتباره من أقدم المصادر
ص: 263
الحديثية، إذ يعود تأليفه إلى القرن الرابع الهجري ، ومن أهمّها لدى الإماميّة؛ لما يشتمل عليه من روايات كثيرة هي محطّ اهتمامهم واعتمادهم .
ورغم أنّا لا نؤمن بصحّة كلّ ما رواه المرحوم الكليني قدس سره، فإنّنا سنفترض هنا الاعتماد على هذه الروايات؛ لأنّه قدس سره صرّح في مقدّمته بأنّه نقلها عمّن يثق بعلمه استجابةً للسائل ، وإن كان ذكر بعضها في النوادر ، وأكّد على لزوم الأخذ بالمجمع عليه دون الشاذّ النادر ، كما جاء في الرواية . وسنشير في الخاتمة إلى هذا الأمر ، ونحن بصدد الوصول إلى الصورة الّتي تتكوّن من اتّباع هذه الروايات عن القرآن الكريم في خلد المسلم العامل به .
ولعلّ أهمّ ما في أُصول الكافي مشيراً إلى هذه الصورة، جاء في بابين، هما :
1 - باب الدعاء ، وبالخصوص الدعاء عند قراءة القرآن وحفظه(1) .
2 - باب فضل القرآن(2) .
فهما إذن محطّ إشارتنا . وسنشير هنا وفق ثلاثة خطوط كما يلي :
وهنا تركّز الروايات أروع صورة عقدية خالصة عن أُصول العقيدة، وأهمّها التوحيد ، وما يتبعه من تصوّر للصفات الإلهيّة ، فتؤكّد أنّ الإمام الصادق عليه السلام كان يدعو عند قراءة كتاب اللّه عزّ وجلّ قائلاً :
اللّهمّ ربّنا لك الحمد ، أنت المتوحّد بالقدرة والسلطان المتين ، ولك الحمد أنت المتعالي بالعزّ والكبرياء ، وفوق السماوات والعرش العظيم ، ربّنا ولك الحمد يا منزل الآيات والذكر العظيم ، ربّنا فلك الحمد بما علّمتنا من الحكمة والقرآن العظيم المبين . اللّهمّ أنت علّمتناه قبل رغبتنا في تعليمه ، واختصصتنا به قبل رغبتنا بنفعه .
ص: 264
اللّهمّ فإذا كان ذلك منّاً منك وفضلاً وجوداً ولطفاً بنا ورحمةً لنا وامتناناً علينا من غير حولنا ولا حيلتنا ولا قوّتنا . اللّهمّ فحبّب إلينا حسن تلاوته ، وحفظ آياته ، وإيماناً بمتشابهه ، وعملاً بمحكمه ، وسبباً في تأويله ، وهدىً في تدبيره، وبصيرةً بنوره . اللّهمّ وكما أنزلته شفاءً لأوليائك ، وشقاءً على أعدائك ، وعمىً على أهل معصيتك ، ونوراً لأهل طاعتك ، اللّهمّ فاجعله لنا حصناً من عذابك ، وحرزاً من غضبك ، وحاجزاً عن معصيتك ، وعصمةً من سخطك ، ودليلاً على طاعتك ، ونوراً يوم نلقاك نستضيء به في خلقك ، ونجوز به على صراطك ، ونهتدي به إلى جنّتك(1) .
وواضح التركيز العقائدي على :
التوحيد بمعانيه ، والصفات الإلهيّة الحسنى ، من: الحياة، والقدرة، والعلم والغنى، والحكمة، واللطف، والرحمة وغيرها ، والتركيز على الإيمان بالرسالة عبر إنزال القرآن ، وعبر التمسّك به واستمداد الهدى منه، واللجوء إليه استعداداً للآخرة، والجواز على الصراط، والتنعّم بالجنّة .
ومن هذا المنطلق العقائدي الرصين تتدفّق المعاني والتوجيهات الكثيرة، ومنها :
1 - إنّ القرآن يفتح آفاق العلم والمعرفة ، حيث تأتي الاستعاذة من الشقاء في حملِهِ، والعمى عن علمه، والجور عن حكمه والعلوّ عن قصده ، والتقصير دون حقّه(2) .
ويستمرّ الدعاء على هذا النحو :
اللّهمّ اجعل لقلوبنا ذكاءً عند عجائبه الّتي لا تنقضي ، ولذاذةً عند ترديده، وعبرةً عبر ترجيعه، ونفعاً بيّناً عند استفهامه . . . اللّهمّ اجعله لنا زاداً تقوّينا به في الموقف بين يديك ، وطريقاً واضحاً نسلك به إليك ، وعلماً نافعاً نشكر به نعماءك(3) .
ص: 265
وتقول الرواية في موضعٍ آخر :
فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن؛ فإنّه شافعٌ مشفَّعٌ ، وماحلٌ مصدَّقٌ ، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، وهو الدليل يدلّ الإنسان على خير سبيل، وهو كتابٌ فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل ، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق ، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تُحصى عجائبه ، ولا تُبلى غرائبه ، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة ، فليجلُ جالٍ بصرَه ، وليبلغ الصفةَ نظره ، ينج من عطب ، ويتخلّص من نشب ، فإنّ التفكّر حياة البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور ، فعليكم بحسن التخلّص وقلّة التربّص(1) .
ويقول الإمام علي بن الحسين عليه السلام :
آيات القرآن خزائن، فكلّما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر فيها(2) .
2 - القرآن هو الحجّة المنجزة والمَعذرة ومعيار الحقّ .
والروايات كلّها تشعّ بهذا الأمر، منها قوله عليه السلام :
فإنّك اتّخذت به علينا حجّة قطعت به عذرنا ، واصطنعت به عندنا نعمةً قَصَر عنها شكرنا . اللّهمّ اجعله لنا شافعاً يوم اللّقاء ، وسلاحاً يوم الارتقاء ، وحجيجاً يوم القضاء(3) .
3 - وهو الصورة الأسمى للإنسان الكامل، حيث تذكر الروايات أنّ القرآن سيتمثّل بشكلٍ مجسّد يوم القيامة، فيظنّه المسلمون والشهداء والنبيّون والملائكة أنّه رجل منهم(4) .
ص: 266
4 - وهو معيار دقيق للفهم التاريخي السليم(1) ، فمن خلال ما يشير إليه من سنن يمكن اكتشاف الحقائق التاريخية .
5 - القرآن جامع لتعاليم الأنبياء، ومهيمن على الكتب السابقة(2) .
إلى ما هنالك من تصوّرات تؤكّدها النصوص .
والنصوص في هذا المورد حافلة بالمعاني متنوّعة الأساليب إلى حدٍّ معجز ، تعمّق القرآن في المشاعر ، وتربط التأثّرات بالمعاني أروع ربط، وتؤكّد على قراءته وحفظه والتفاعل مع معانيه . فلنتابع بعض هذه النصوص بكلّ تأمّل ووعي .
في دعاء الإمام الصادق عليه السلام عند قراءة القرآن، نلاحظ هذا المقطع :
اللّهمّ ارزقنا حلاوةً في تلاوته ، ونشاطاً في قيامه، ووجلاً في ترتيله ، وقوّةً في استعماله في آناء اللّيل وأطراف النهار . اللّهمّ واشفنا من النوم باليسير ، وأيقظنا في ساعة الليل من رُقاد الراقدين ، ونبّهنا عند الأحايين الّتي يُستجاب فيها الدعاء من سِنة الوَسنانين(3) .
وبعد أنواع عظيمة من القسم بأسماء اللّه، يسأل الداعي ربّه قائلاً :
أسألك أن تصلّي على محمّدٍ وآل محمّد، وأن ترزقني حفظ القرآن وأصناف العلم ، وأن تثبّتها في قلبي وسمعي وبصري ، وأن تخالط بها لحمي ودمي وعظامي ومخّي ، وتستعمل بها ليلي ونهاري، برحمتك وقدرتك(4) .
وفي دعاءٍ آخر :
وألزم قلبي حفظ كتابك كما علّمتني ، وارزقني أن أتلوه على النحو الّذي يرضيك
ص: 267
عنّي . اللّهمّ نوّر بكتابك بصري ، واشرح به صدري ، وفرّح به قلبي ، وأطلق به لساني ، واستعمل به بدني(1) .
وفي الرواية، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله :
تعلّموا القرآن ؛ فإنّه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شاب جميل شاحب اللّون، فيقول له القرآن : أنا الّذي كنتُ قد أسهرتُ ليلَك وأظمأتُ هواجرَك وأجففتُ ريقَك وأسلتُ دمعتَك ، أؤول معك حيثما أُلتَ(2) .
ويقول الإمام الصادق عليه السلام :
من قرأ القرآن وهو شابٌّ مؤمنٌ ، اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله اللّه عزّ وجلّ مع السفرة الكرام البررة(3) .
ويقول عليه السلام :
ومن أُوتي القرآنَ فظنّ أنّ أحداً من الناس أُوتي أفضلَ ما أُوتي، فقد عظّم ما حقّر اللّه، وحقّر ما عظّم اللّه (4) .
وقارئ القرآن في تطوّرٍ مستمرّ، فهو حالٌّ مرتحلٌ(5) .
وحملة القرآن عُرفاء أهل الجنّة(6) .
ويأتي التأكيد على ختم القرآن وتنوير البيوت بالقرآن(7)، والحثّ على قراءته في كلّ حال(8) ، وختم القرآن في مكّة خلال أُسبوع(9)، وترتيل القرآن بصوتٍ
ص: 268
حسن(1)، ويقول الإمام الصادق عليه السلام :
إنّ القرآن لا يُقرأ هَذرَمةً، ولكن يُرتّل ترتيلاً، فإذا مررت بآيةٍ فيها ذكر الجنّة، فقف عندها وسلِ اللّه عزّ وجلّ الجنّة، وإذا مررت بآيةٍ فيها ذكر النار، فقف عندها وتعوّذ باللّه من النار(2) .
ثمّ يأتي ذكر فضل قراءة السور(3) .
وبطبيعة الحال يأتي تأطير كلّ السلوك بإطار القرآن، فيجعل معياراً عامّاً له وضابطاً لكلّ حركة ، فيقول الإمام في الدعاء :
اللّهمّ اجعلنا نتّبع حلاله، ونجتنب حرامه، ونقيم حدوده، ونؤدّي فرائضه(4) .
وفي مقطعٍ آخر:
اللّهمّ اجعله لنا وليّاً يثبّتنا من الزلل، ودليلاً يهدينا لصالح العمل ، وعوناً هادياً يقوّمنا من الميل، حتّى يبلغ بنا أفضل الأمل(5) .
ويقول الصادق عليه السلام :
وهو الدليل يدلّ على خير سبيل(6) .
إنّ روايات الكافي تربّي الإنسان القرآني الكامل ، تصوغ له عقيدته ومفاهيمه القرآنية، وتزكّيه وتربّيه على التخلّق بأخلاقه والتفاعل معه، كما تعطيه الإطار القرآني للسلوك،
ص: 269
فالقرآن حينئذٍ كلّ شيء في حياته ؛ يسمع به ويبصر به وينطق به .
ومع كلّ ما سبق نجد أنّ المرحوم الكليني قدس سره يعطي القرآن في كتابه أعظم المقام، ويجلّه أكبر الإجلال، ويدفع الأجيال - وخصوصاً أتباع مدرسة أهل البيت - لبناء أنفسهم وفقه وتصحيح كلّ تصوّراتهم بمعياره، والتفاعل معه كلّ التفاعل .
ومع هذا لا يبقى مجال للاستماع إلى تهمة موجّهة إليه قدس سره من أنّه شكّك في حجّيته ، أو آمن بتحريفه ، وبالتالي خرج على الإجماع الإسلامي بسلامته من التحريف، وإنّه ذكر إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنّ اللّه تعالى هو
الّذي نزّله وهو الّذي تكفّل بحفظه ، فإنّ كلّ هذه النسب لا يبقى لها مجال .
ولكن لنتعرّض إليها عرضاً ونقول الحقّ دفاعاً عن هذا العالم النحرير والمحدّث الجليل .
تعدّ نسبة القول بالتحريف لشيخنا الكليني من أخطر التهم الموجّهة إليه . وهذا الخطأ ارتكبه المرحوم الفيض الكاشاني، حيث قال :
فالظاهر من ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني - طاب ثراه - أنّه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن(1) .
الأمر الّذي أدّى إلى نتيجة أكثر خطراً، وهي (التكفير)، حيث استند الشيخ محمّد أبو زهره إلى هذه النسبة، وأقدم على تكفيره قائلاً :
ومن الغريب أنّ الّذي ادّعى هذه الدعاوي الكليني، وهو حجّة في الرواية عندهم ، وكيف تُقبل رواية من يكون على هذا الضلال ، بل على هذا الكفر المبين(2) .
والحقيقة هي أنّ المرحوم الكليني لم يصرّح بذلك أبداً ، ونقله لبعض الروايات
ص: 270
في باب «إنّه لم يجمع القرآن كلّه إلاّ الأئمّة»(1)، لا يعني الإيمان بالتحريف ، ورواياته إنّما تركّز على الاختلاف في كيفية ترتيب النزول ، وجمع القرآن ، وعلم القرآن وتفسيره، وهي بعيدة عن التحريف .
وكذلك باب «النوادر في فضل القرآن»(2)، ورواياته بين مؤكّدة على حفظ الحروف وتضييع المعاني ، وبين التركيز على أنّ علمهم عليهم السلام بتفسير القرآن وعلومه أكثر من غيرهم ، وكلّ هذا لا يعني الالتزام بالتحريف .
ثمّ إنّه موسوعي ينقل الروايات الّتي يعتمد على إسنادها، ولا يعني ذلك الإيمان بكلّ مضامينها، خصوصاً وأنّه نقلها في باب «النوادر»، ممّا يجعلها مشمولة لمنهجه الواضح في رفض الشاذّ النادر، عملاً برواية: «ودع الشاذّ النادر»(3) .
الأهمّ من ذلك أنّها لا تدلّ على التحريف، وإنّما على اختلاف في تحديد الآيات ، أو على التحريف المعنوي، كما دلّت عليه رواية أُخرى نقلها المرحوم، إذ تقول :
وكان من نبذهم الكتاب أنّهم أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده(4) .
أو على الاختلاف في ترتيب الآيات، وما إلى ذلك .
أمّا (التكفير) فهو أمر تسرّع فيه الشيخ أبو زهرة ، فظلم المرحوم الكليني بذلك .
وناقش الأمر المرحوم أُستاذنا السيّد محمّد تقي الحكيم، فقال :
فرواية هذه الأحاديث في الشواذّ النوادر من كتابه ، وتعارضها مع مروياته ، ولزوم طرحها بالنسبة إلى منهجه الّذي رسمه ، وعدم التلازم بين الإيمان بالصدور - لو آمن بصدورها - وبين الإيمان بمضمونها ، كلّ ذلك ممّا يوجب القطع بطرحه لهذه الأخبار ، وإيمانه بعدم التحريف . على أنّ التحريف لو كان مذهباً له لما صحّ دعوى الشيخ كاشف الغطاء وغيره إجماع الإمامية على عدم التحريف، ومثل الكليني ممّن
ص: 271
لا يتجاهل أمره عادة(1) .
ولكنّي أعود فاؤكّد أنّه لا توجد رواية في الكافي يُستفاد منها التحريف بصراحة . وما تُوهّم منه ذلك ذكره في النوادر . فهو إذن بريء من هذه التهمة ، عامل على نشر القرآن وصياغة الإنسان صياغة قرآنية فريدة .
ص: 272
لم يسعَ هذا البحث ضمن أولوياته إلى إثبات سلامة القرآن الكريم من عامل التحريف ؛ ذلك بأنّ هذا الأمر تعهّده أصحابه من علماء الشيعة(2) ، فتارةً أفردوا لهذا الموضوع أبوابا من مصنّفاتهم في علوم القرآن ، وتارةً أُخرى ألّفوا فيه المصنّفات المتخصّصة ، فبسطوا القول فيه وبحثوا وحقّقوا ، وخرجوا بنتيجة لا تقوم على تبرئة ساحة الشيعة من التهم الملصقة بهم زورا بالقول بتحريف القرآن فحسب ؛ بل سعوا إلى تنزيه القرآن الكريم نفسه والقطع بأنّه أنزه وأكبر إعجازا من أن يتطرّق إليه التحريف ؛ لأنّه الثقل الأكبر الذي خلّفه رسول اللّه فينا مَن تمسّك به لن يضلّ أبدا .
ص: 273
فضلاً عن أنّه دستور هذه الأُمّة ومقياس تشريعها ، والفرقان بين الحقّ والباطل ، قال تعالى : «تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِى لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا»(1) ، فكيف يكون المقياس محرّفا ؟! بل أنّى لعاقلٍ أن يظنّ بأنّ هذا الفرقان يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه ! وقد قال عزَّ من قال : «لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنم بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِى تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ»(2) ، وقد وعد اللّه - ولا يخلف اللّه وعده - بأنّه لهذا الذكر لحافظ ، فقال : «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُو لَحَافِظُونَ»(3) ، ولا يخفى على القارئ الواعي لآية الحفظ - قراءةً دلاليّةً - أنّ فيها من المؤكّدات ما يوائم الدلالة المبتغاة منها ؛ إذ إنّ التعبير القرآني فيها مسوق بلفظ الجمع دون المفرد « إنّا - نحن - نزّلنا - حافظون » ، للدلالة على التفخيم والقوّة والقدرة الموجودة في الجماعة ، فضلاً عن ورود جملة وعد الحفظ بصيغة الجملة الاسمية الدالّة على الثبوت .
وتصدّر هذه الجملة القرآنية بحرف المعنى « إنّ » التوكيدية ؛ لتوكيد المسند إليه من جهة ، وتوكيد المسند وتقويته من جهةٍ أُخرى ، واقتران المسند بلام التوكيد زيادةً في توثيقه وتقويته ، فجاء موثّقا من جهتين ، فضلاً عن تقديم المتعلّق الأوّل وإظهاره « له » والمقصود به الذكر ؛ للاختصاص والقصر وإضمار المتعلّق الثاني « من التحريف والضياع والنسيان » ، فجاء المسند مقيّدا من جهة المحفوظ ، ومطلقا من جهة المحفوظ منه .
وهذا التعبير الإعجازي فيه من القوّة والتأكيد ما يدحض كلّ الشبهات أو الشكوك التي قد تطرق الأذهان في أنّ هذا النصّ المعجز يمكن أن يصيبه ما أصاب الكتب السماوية السابقة من تحريف ، وأمثال هؤلاء قد تكفّل القرآن الكريم بتوصيفهم في
قوله عز و جل : «فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُم بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ»(4) ،
ص: 274
وقال : «لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِى شِقَاقِم بَعِيدٍ»(1) .
وقد تراكمت هذه الأمراض والأوهام في هذه القلوب ، حتّى عدّوا زيفهم حقيقةً وظنّوا أنّ باطلهم حقّ ، وانحرافهم موضوعية ، وهذا نابع من تمسّكهم بثقافة مسمومة قوامها الاستبداد برأيهم وتسقيط الرأي الآخر ؛ لإبعاده عن الساحة ؛ بغية زرع الفتن الطائفية من جهة ، وفتح منفذ لأعداء هذه الأُمّة للولوج منه ونفث السموم في صحّة المعتقد من جهةٍ أُخرى ، ولكن أنّى لهم هذا! وفي هذه الأُمّة الإسلامية أعلام منصفون من كلتا الطائفتين ، يتبارون في الدفاع عنها وتحرّي الحقّ والعدالة ؛ ليعطي لكلّ ذي حقٍّ حقّه ، ويضع الأُمور في مواضعها .
وبالرغم من ذلك وُجِد هناك من اتّخذ منهجا سقيما(2) وهو يدّعي الموضوعية ، فأخذ يكيل التهم جزافا إلى علمائنا الأجلاّء ، متّخذا من القراءة السطحية للنصوص والروايات مستندا للطعن والتوهين ، فأحيانا يدلّس محرِّفا أقوال العلماء بتقطيع نصوصهم ، فيأخذ منها ما يوافق هواه تاركا ما يدحض شبهاته ، وأحيانا أُخرى يزعم ويضع عليهم أقوالاً لم يقولوا بها ألبتّة ، ولم يشيروا إليها لا تصريحا ولا تلميحا . وهذه التهم نجدهم قد وجّهوها إلى المحدّث الفقيه الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي ، وهو أشهر من أن نُعرِّف به .
لقد استند القائلون باتّهام الشيخ الكليني بالقول بتحريف النصّ القرآني على أُسس ثلاثة :
1 - إنّه روى روايات تنصّ على معنى التحريف والنقصان في القرآن الكريم .
2 - إنّه لم يتعرّض لهذه الروايات بالنقد لا سندا ولا متنا ، وهذا يدعو إلى القول بأنّ
ص: 275
هواه ومعتقده يتّفق وهذه الروايات .
3 - إنّه ذكر أوّل كتابه أنّه يثق بكلّ ما رواه ، وعلى هذا فهو يرى صحّة هذه الروايات القائلة بتحريف النصّ القرآني ، ما يفضي إلى القول بأنّه يتبنّى هذا المعتقد(1) .
وللوقوف على حقيقة موقف الشيخ الكليني ، ومحاولة الكشف عن صدق نسبة هذه التهم إليه ، لابدّ لنا من أن نقف عند كلّ من هذه الأدلّة فنخضعها للمناقشة ؛ بغية اقتناص الدلائل التي تدين أو تبرئ ساحته من هذه التهم التي أُشيعت وشنعت به .
ومن البديهي أنّ هناك شرائط ومقدّمات لابدّ من أن تتوافر عند صاحب المعتقد - أيّ معتقد - لاستقامة القطع بمعتقده ، وقد وضع بعض العلماء شرائط لاستقامة نسبة عقيدة التحريف عند صاحب الكتاب ، منها :
1 - تعهّد صاحب الكتاب بصحّة ما يرويه على الإطلاق تعهّدا صريحا شاملاً .
2 - ظهور تلك الأحاديث في التحريف ظهورا بيّنا ، بحيث لا يحتمل تأويلاً أو محامل أُخر ، معتمدة على أدلّة عقلية أو نقل متواتر .
3 - عدم وجود معارض لها بحيث يترجّح عليها بحسب نظر صاحب الكتاب .(2)
وسنقف عند كلّ من هذه المقدّمات ، لنرى مدى توافرها في كتاب الكافي للشيخ الكليني ، حتّى يصحّ أن يوصم بهذه الوصمة .
تقوم هذه المقدّمة على أساس أنّ الكليني تعهّد بصحّة جميع ما رواه على الإطلاق تعهّدا شاملاً ، على فرض أنّ الروايات قائلة بالتحريف بالمعنى المتنازع فيه ، وهذا ما لا يجده المتتبّع لكتاب الكافي تتبّعا موضوعيا دقيقا البتّة ؛ إذ لم يرد هناك نصّ واحد أو
ص: 276
إشارة صريحة إلى أنّه يقول بصحّة كلّ ما يرويه ، بل على خلاف ذلك نراه في مقدّمة كتابه يقول :
يا أخي - أرشدك اللّه - أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلفت الرواية فيه عن العلماء برأيه ، إلاّ على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله : اعرضوها على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه عز و جل فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فردّوه(1) .
نلمح من مقالته هذه أنّه يقرّ أن ليس بوسعه ولا غيره تمييز الصحيح من غيره إذا اختلفت رواياته عن أهل البيت عليهم السلام ، إلاّ بعرضه على كتاب اللّه ، فما وافقه يعدّ صحيحا ، وما خالفه يعدّ مردودا . فهو لم يضع شرطا لصحّة رواياته غير مقال الإمام عليه السلام ، ولم يقطع بصحّتها ، إلاّ على هذا الشرط ، لذا نراه يروي روايات عن أهل البيت عليهم السلام في هذا المعنى ، ومن ذلك ما رواه عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال :
قال رسول اللّه عليه السلام : إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه(2) .
إنّ رواياته هذه دليل على القول بعدم وقوع التحريف في القرآن الكريم ، وذلك من جهتين :
الاُولى : إنّ المعروض عليه يجب أن يكون مقطوعا به ؛ لأنّه المقياس الفارق بين الحقّ والباطل ، ولا موضع للشكّ في نفس المقياس .
إذن لو عُرضت روايات التحريف على نفس ما قيل بسقوطه لتكون موافقة له ، فهذا عرض على المقياس المشكوك فيه ، وهو دور باطل ، وإن عُرضت على غيره فهي تخالفه . . . .
الجهة الثانية : إنّ العرض لابدّ أن يكون على هذا الموجود المتواتر لدى عامّة المسلمين ؛ لما ذكرناه في الجهة الاُولى من أنّ المقياس لابدّ من أن يكون مقطوعا به . . . ولا يجوز أن يكون المراد بالكتاب المعروض عليه غير هذا المتواتر الذي بين
ص: 277
أيدينا وأيدي الناس ، وإلاّ لزم التكليف بما لا يطاق، فقد ثبت وجوب عرض الأخبار على هذا الكتاب ، وأخبار النقيصة إذا عُرضت عليه كانت مخالفة له(1) .
وإذا قلنا بأنّ نقل الروايات تنمّ عن معتقد ناقلها ، فإنّنا سنجزم بأنّ الكليني من القائلين باستحالة وقوع التحريف في القرآن الكريم .
ومن جهة أُخرى نراه يقول معتذرا :
وقد يسّر اللّه - وله الحمد - تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت ، فمهما كان فيه من تقصير فلم نقصر نيّتنا في إهداء النصيحة ؛ إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملّتنا(2) .
ويُفهم من كلامه هذا أنّه اجتهد ما وسعه الاجتهاد في جمع الأحاديث بمختلف أسانيدها ، وترك الأمر للمتحرّي أن يعرض هذه الأحاديث على كتاب اللّه ، ليكون فيصلاً في تمييز الصحيح من المردود .
وممّا يشفع للكليني أنّه لم يسمّ كتابه صحيحا كما سمّى جامع البخاري ومسلم ، ولم يذهب إلى ما ذهب إليه البخاري بأنّه لم يخرّج في هذا الكتاب إلاّ ما صحّ عنده(3) على حين أنّه روى روايات ضعيفة(4) ، ولم يقل أحد من علماء الشيعة إنّه : « لا يخرّج إلاّ عن الثقة من مثله في جميع الطبقات »(5) ، مع أنّه يروي عن ليث بن مسلم وغيره من الضعفاء(6) . وكذلك لم يقل فيه أحد كما قال الشافعي في حقّ الموطّأ : « أصحّ الكتب بعد كتاب اللّه الموطّأ »(7) .
ص: 278
ولو سلّمنا جدلاً مع القائلين بأنّ الكليني يثقّ بكلّ ما رواه - مع ما ذكرنا من أدلّة على بطلان هذه الدعوى - على افتراض أنّه روى روايات فيها معنى التحريف والنقيصة ، فالأولى بنا أن نأخذ أصحاب الصحاح بهذه التهمة ؛ لأنّهم صرّحوا بأنّ كلّ ما رووه صحيحا على وفق شروطهم التي اشترطوها ، وهم قد رووا كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي تقول بوجود تحريف في النصّ القرآني . وسنذكر باختصار أمثلة منها؛ تجنّبا للإطالة ، ولأنّ الباحثين قد أسهبوا بحصر هذه الروايات(1) .
فمن القول بالزيادة ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عبّاس أنّه قرأ : «وَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَ لاَ نَبِىٍّ - ولا محدّث - إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى»(2) ، بزيادة « ولا محدّث » .
ومن النقصان ما في الإتقان بسنده عن ابن مسعود أنّه قرأ : « والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى والذكر والاُنثى » بحذف « وما خلق »(3) .
ومن التبديل في الألفاظ ما في مسند أحمد وصحيح الترمذي والمستدرك عن ابن مسعود أنّه قال : « أقرأني رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّي أنا الرزّاق ذو القوّة المتين »(4) .
فلو جاز أن تُكال التهم للكليني بالقول بالتحريف ، لكان من باب أولى أن يقال هذا في أصحاب الصحاح ؛ لأنّهم ألزموا أنفسهم برواية كلّ حديث صحيح ، ولكن لم يقل أحد من علماء الشيعة أو السنّة بذلك ، فلِمَ هذا الكيل بمكيالين ؟ ! على حين أن الكليني لم يصرّح بوقوع التحريف ، كما لم يصرّح أحد من علماء الشيعة .
إنّ هذه المقدّمة قوامها الروايات والأحاديث التي رواها الكليني ، والتي ادّعى
ص: 279
المتّهمون إيّاه أنّها دليل الاتّهام الأوثق التي تنصّ على قوله بتحريف القرآن ، وقد كان استدلالهم بهذه الروايات من جهتين :
1 - إنّهم حكموا على هذه الروايات بأنّها نصّ في القول بتحريف النصّ القرآني .
2 - عدّوا الكليني معتقدا بها ؛ كونه لم يتعرّض لنقدها أو قدحها .
أمّا الروايات التي زعموا أنّها قائلة بتحريف القرآن واتّخذوها مادّة لاتّهام الكليني ، فقد قسّمها الباحثون على أقسام(1) .
1 - الروايات التي وردت في شأن مصحف الإمام عليّ عليه السلام .
2 - روايات الفساطيط التي تُضرب بظهر الكوفة عند ظهور القائم ( عجّل اللّه فرجه الشريف ) .
3 - الأحاديث التي وردت فيها لفظة التحريف .
4 - الروايات التي دلّت على أنّ بعض الآيات المنزلة من القرآن فيها أسماء الأئمّة عليهم السلام .
5 - الروايات التي دلّت على التحريف في القرآن بالنقيصة .
6 - قراءات منسوبة إلى بعض الأئمّة عليهم السلام .
والأظهر أنّ القسمين الأوّل والثاني يمكن أن يندرجان في عنوان القسم الأوّل ، على حين أنّ الأقسام الأربعة الأُخرى تندرج تحت عنوان الروايات التي توهم بوجود تحريف في النصّ القرآني ، إذا أخذنا بالحسبان المعنى الأشمل لمصطلح التحريف . تأسيسا على هذا وسيرا في سبيل الإجمال سوف نقسّمها على قسمين :
القسم الأوّل : الروايات التي تقول بوجود مصحف الإمام علي عليه السلام الذي يخالف هذا المصحف ، وسيظهر مع ظهور القائم ( عجّل اللّه فرجه ) .
نقول : إنّ القول بوجود هذا المصحف متّفق عليه بين علماء الفرقتين(2) ، وقد روى
ص: 280
الكليني في الكافي عن سالم بن سلمة أنّه قال :
قرأ رجل على أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ؛ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : كفّ عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرأ الناس حتّى يقوم القائم عليه السلام . وقال : فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب اللّه عز و جل على حدّه ، وأخرج المصحف الذي كتبه عليّ عليه السلام . وقال : أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه ، فقال لهم : هذا كتاب اللّه عز و جلكما أنزله اللّه على محمّد صلى الله عليه و آله وسلم ، قد جمعته من اللوحين ، فقال : هو ذا عندنا مصحف جامع لا حاجة لنا فيه ، فقال : أما واللّه ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا ، إنّما كان عليَّ أن أُخبركم حين جمعته لتقرؤوه(1) .
وروي أيضا عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال :
ما ادّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّه كما أُنزل إلاّ كذّاب ، وما جمعه وحفظه كما أنزله اللّه تعالى إلاّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام والأئمّة من بعده عليهم السلام(2) . وقال عليه السلام : ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن ظاهره وباطنه غير الأوصياء(3) .
إنّ القراءة الفاحصة في هذه النصوص الثلاثة توقفنا على أُمور ، منها :
1 - قوله في النصّ الأوّل : « قرأ رجل على أبي عبد اللّه حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس
» ، وقول الإمام علي : « إنّما كان عليَّ أَن أُخبركم حين جمعته لتقرؤوه » .
2 - قول الإمام : « ما ادّعى أحد من الناس جمع القرآن كلّه كما أُنزل » ، وقوله : « وما جمعه وحفظه كما أنزله اللّه تعالى إلاّ عليّ » .
3 - قوله : « جميع القرآن ظاهره وباطنه » .
إنّ النظرة السطحية الظاهرية لهذه النصوص تُوصل إلى فكرة مفادها أنّ مصحف الإمام عليّ عليه السلام يختلف في جوهره وشكله عن نصوص الآيات القرآنية الموجودة في القرآن الكريم ، ولكنّ القراءة الدلالية الواعية للنصّين توقفنا على وجود اختلاف بين
ص: 281
المصحفين ، لا بالجوهر ، بل بالشكل فقط ، وهذا ما قال به علماء المسلمين من كلتا الطائفتين(1) .
ويعود الاختلاف إلى أمرين :
الأوّل : هو أنّ ترتيب مصحف الإمام يباين ترتيب المصحف الموجود ؛ كون الأوّل مرتّبا على النزول ، حيث روى ابن عبد البرّ عن ابن سيرين قوله :
فبلغني أنّه كتبه على تنزيله ، ولو أُصيب ذلك الكتاب لكان فيه علم(2) .
وقال السيوطي :
جمهور العلماء اتّفقوا على أنّ ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة ، وأنّ ابن فارس استدلّ لذلك بأنّ منهم من رتّبها على النزول ، هو مصحف علي ، كان أوّله : اقرأ، ثمّ نون، ثمّ المزمّل . هكذا ذكر السور إلى آخر المكّي ثمّ المدني(3) .
وبهذا قال أعلام الشيعة قدماء ومحدثين(4) .
والوجه الآخر في الاختلاف : إنّ هناك زيادات كانت موجودة في هذا المصحف ، لكنّها زيادات ليست من النصّ القرآني ، بل هي من قبيل التفسير والتأويل ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، وغير ذلك ؛ لذا قالوا فيه : إنّه لو أُصيب فيه لكان فيه علم ، وليس أدلّ على ذلك من قول الشيخ المفيد :
قد جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن المنزل من أوّله إلى آخره ، والذي يجب فيه ما وجب من تأليفه ، فقدّم المكّي على المدني ، والمنسوخ على الناسخ ، ووضع كلّ شيء منه في موضعه(5) .
وهذا ما عناه بلفظ الإنزال والتنزيل في قوله : « كما أنزله اللّه تعالى » ؛ إذ « قد
ص: 282
يُستعمل ويراد به ما نزل مطلقا ، لا ما اصطلح عليه المتأخّرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآنا فقط » ، وبهذا قال علماء الشيعة(1) .
أمّا معنى لفظ الإقراء فهو :
على عهد الرسول إلى سنوات قليلة من بعده ، تعليم تلاوة اللفظ مع تعليم معناه اصطلاحا ، والمقرئ مَن يعلّم تلاوة لفظ القرآن مع تعليم معنى اللفظ . . . وأصبح بعد انتشار تعلّم القرآن يُستعمل الإقراء في أحد المعنيين ، وهو تعليم معنى الآيات التي تحتاج إلى تفسير(2) .
فعلى هذا قوله : « قرأ على الإمام حروفا من القرآن ليست ممّا يقرأ الناس » ، فلا يقصد به أنّه قرأ آيات من نصّ القرآن بألفاظها ، بل المراد تفسير معانيها ، ويشهد لذلك قول ابن مسعود :
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ - إنّ عليّا مولى المؤمنين - وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»(3) ، هكذا كنّا نقرأ الآية على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله (4) .
فابن مسعود لا يعني أنّ عبارة : « إنّ عليّا مولى المؤمنين » هي من لفظ النصّ القرآني أو أنّها جزء من الآية ، لكنّه يعني من هذه العبارة التعليم والإبانة ، فهو في مقام تعليم الآية وتفسيرها(5) .
ولاشكّ في أنّ الكليني - وهو الشيخ الفقيه - على معرفة ودراية بأنّ هذه المصطلحات تقوم على هذه المفاهيم ، لذا لم يتعرّض لنقد ما روى من الأحاديث والروايات التي وردت فيها هذه المصطلحات ، بل لم تكن له حاجة إلى نقدها والقدح فيها ؛ لأنّها مفهومة لديه ، بل إنّ هذا من المتسالم لديه ولدى علماء عصره .
ص: 283
وممّا يدلّ على أنّ مصطلح « الإقراء » وارد بهذا المعنى ، نرى الشيخ الكليني يذكر مصطلح « تلا » في مواضع كثيرة من كتابه ، حينما يريد نصّ الآية من دون تفسيرها(1) ، بمعنى أنّ التلاوة تخصّ اللفظ دون المعنى ، على حين أنّ الإقراء يخصّ اللفظ والمعنى معا ؛ وبهذا تتهافت هذه الحجّة التي أخذ بها المتّهمون على الكليني .
وتقوم روايات الفساطيط دليلاً آخر على صحّة ما نقول ، من ذلك ما رواه الكليني عن الإمام : « إذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب اللّه على حدّه ، وأخرج المصحف الذي كتبه عليّ»(2) ، والمقصود من القراءة هنا التلاوة والتفسير ، أي قرأه « على نسجه الأوّل الأصيل ، وفق ما أنزل اللّه تماما من غير تحوير ، وعدم فوت شيء من خصوصيات النزول زمانا ومكانا وموردا ، وغير ذلك من الوجوه الذي يتضمّنه مصحف أمير المؤمنين عليه السلام »(3) .
القسم الثاني : الروايات القائلة بتحريف النصّ القرآني ، وتشمل :
1 - أحاديث وردت فيها لفظة التحريف نصّا .
2 - الروايات التي دلّت على أنّ بعض الآيات المنزلة من القرآن فيها أسماء الأئمّة عليهم السلام .
3 - الروايات التي دلّت على التحريف في القرآن بالنقيصة .
4 - قراءات منسوبة إلى بعض الأئمّة عليهم السلام .
للوقوف على الدلالة الحقيقية لهذه الروايات ، لابدّ من تحديد مصطلح التحريف ، وبيان المقصود من التحريف في المعنى المتنازع عليه .
إنّ التحريف في اللغة هو مصدر من الفعل « حرّف » ، والثلاثي منه « حرف » ، ويرد متعلّقا بحرف المعنى « عن » الدالّة على التجاوز ، لذا يعني التحريف العدول والميل « الرجوع » عن الشيء ، والقلم المحرّف هو الذي عَدل بأحد حرفيه عن
ص: 284
الآخر(1) . وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم وأُريد بها التغيير بالمعنى ، حيث قال سبحانه : «مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ»(2) ، وقال أيضا : «وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنم بَعْدِ مَوَاضِعِهِ»(3) .
أمّا معنى التحريف في الاصطلاح ، فقد ذهب بعض الدارسين إلى أنّه يحمل سبعة أوجه ،(4) وإذا أخذنا المعنى العامّ للتحريف ، نجده لا يخرج عن أحد أمرين :
تحريف لفظي : ويشمل تغيير مفردات النصّ القرآني من زيادةٍ أو نقصان أو تبديل ، وهو المعنى المتنازع فيه .
تحريف معنوي : وهو تفسير الآيات وتأويلها على غير الوجه الذي وردت فيه من شأن نزولها ، والمعنى المراد منها .
أمّا الروايات التي رواها الكليني في الكافي واستدلّوا بها على وقوع التحريف في القرآن الكريم وكانت مدعاة اتّهامه باعتقاد التحريف باختلاف أقسامها ، فلا تدلّ على معنى التحريف بالمعنى المتنازع فيه ، بل إنّها تنحصر في أحد أُمور : فهي إمّا أن تكون من قبيل التفسير والتأويل ، أو بيان تخصيص مصاديق لآية وردت بلفظٍ عامّ ، أو من قبيل اختلاف القراءات . وهذا كلّه يصبّ في المعنى الثاني من التحريف ، وهو التحريف المعنوي .
وسنورد بعضا من هذه الروايات على نحوٍ مختصر وما يتواءم مع هدف البحث ؛ ذلك بأنّ الباحثين قد أسهبوا في ذكرها وتحليلها والوصول إلى هذه النتيجة التي ذكرنا(5) .
ص: 285
ومن الروايات التي ورد فيها لفظ التحريف ، ما رواه عن الباقر عليه السلام في رسالته لسعد الخير :
وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه ، وحرّفوا حدوده ، فهم يروونه ولا يرعونه(1) .
ومنها : روايته عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قرّاء القرآن ثلاثة : رجل قرأ القرآن فاتّخذه بضاعةً واستدرّ به الملوك واستطال به على الناس ، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده وأقامه إقامة القدح(2) .
وقوله عليه السلام أيضا :
ولا تلتمس دين مَن ليس من شيعتك ، ولا تحبنّ دينهم ؛ فإنّهم الخائنون الذين خانوا اللّه ورسوله ، وخانوا أماناتهم ، وتدري ما خانوا أماناتهم ؟ ائتمنوا على كتاب اللّه فحرّفوه وبدّلوه(3) .
والأظهر أنّ مضامين هذه الروايات تقوم أساسا على المعنى الثاني ، وهو حمل الآيات على غير معانيها . يقول السيّد الخوئي :
فهي ظاهرة الدلالة ، على أنّ المراد بالتحريف حمل الآيات على غير معانيها الذي يلازم إنكار فضل أهل البيت عليهم السلام(4) .
وما يعضد ذلك استعماله الفعل « أقام » ، ومعنى الإقامة من أقام العود إذا قوّمه ، أو الدوام ، ومنها إقامة الصلاة . يقول الزمخشري :
ومعنى إقامة الصلاة : تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابها ، مِن أقام العود إذا قوّمه ، أو الدوام عليها والمحافظة عليها . . . من قامت السوق إذا نفقت . . . لأنّها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجّه إليه
ص: 286
الرغبات ويتنافس فيه المحصّلون(1) .
فإقامة الحروف معناه الحرص على حفظ النصّ القرآني تلاوةً بألفاظه وحروفه ، ولكنّهم حرّفوا حدوده ، أي شرائعه وشأنه الذي نزل فيه ، ومثله قوله : « ضيّعوا حدوده » . وفي هذا النصّ « جاء استعمال التضييع موضع التحريف ، وتضييع حدود القرآن هو تركها وعدم العمل وفقها ، كما كان المراد من تحريفها عدم وضعها في موضعها ؛ لأنّه مأخوذ من الحرف بمعنى الجانب »(2) .
وقد ناسب هذه الدلالة أنّه أردفها تأكيدا لها وتقويةً للمعنى المراد بقوله : « فهم يروونه ولا يرعونه » ، فهم حافظوا على النصّ بألفاظه، ولكنّهم أساؤوا التأويل ولم
يرجعوا إلى أئمّتهم ، وهذا هو معنى النبذ ، وهو ترك العمل بمداليله الأصل . ومثل هذا المعنى موجود في النصّ الثاني ، وهو قوله : « وأقامه مقام القدح » ، أي الإناء الذي
يصحبه المسافر ، فإذا ما فرغ من الأكل أو الشرب فيه علّقه على ظهره ؛ كنايةً عن عدم الاهتمام به(3) .
من هذا يتّضح أنّ هذه الأحاديث لا تمسّ جانب تحريف القرآن بالمعنى الاصطلاحي ، أي تطرّق الزيادة والنقصان في النصّ ؛ لأنّ لها تأويلاً صحيحا يتّضح من السياق الذي وردت فيه، والقراءة الدلالية الواعية لهذه النصوص كشفت عن هذه المعنى .
وهذه الروايات بمجملها لا تخرج عن أمرين :
1 - روايات تفسيرية وردت عن المعصوم لبيان مجمل أو شأن نزول أو تعيين
ص: 287
مصداقها المنطبق عليه الآية بعمومها ( تخصيص عامّ ) ، « وقد كان من عادة السلف أن يجعلوا من الشرح مزجا مع الأصل تبيينا وتوضيحا لمواضع الإبهام من غير أن يلتبس الأمر ، اللهم إلاّ على أولئك الذين غشيهم غطاء التعامي »(1) .
فمن هذه الروايات ما رفعه الكليني بإسناد إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قرأ : «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ»(2) ، عقّبها بقوله : « بظلمه وسوء سريرته »(3) ، وفي قوله هذا بيان لكيفية الإهلاك ، فالفعلان « يهلك » و« يفسد » مطلقان من حيث حذف الكيفية ، بحيث يذهب ذهن المتلقّي إلى شتّى أنواع الإفساد والإهلاك ، ولكن جاء نصّ الإمام مفسّرا للمعنى المبتغى من هذه الآية ومقيّدا إيّاه تقييدا .
ومنها : ما ورد بزيادة لفظة « عليّ » ، وهذه الروايات وردت في بيان مصاديق الآية ؛ لورود تلك الآيات عامّة من حيث اللفظ .
وقد ختمت هذه الروايات بقول الإمام : « هكذا نزلت » ، و « هذا تنزيلها » ، و « هذا تأويلها » ، أو لفظة « يعني » .
ولعلّ الذي أوهم الواهمين بأنّ هذه التفسيرات والتوضيحات من النصّ القرآني هو ورودها في درج الآية ، فالإمام يتلو الآية ، ثمّ يقف على المعنى المبهم ليفسّره ، ثمّ يكمل تلاوة الآية . وكذلك كونها دوّنت بهذا الشكل ، لا يعني أنّها من النصّ القرآني .
ومن ذلك الروايات التي تقول بإسقاط أسماء المعصومين من النصّ القرآني(4) ، وهذا النوع هو أكثر الروايات ، وهو تفسير من دون أدنى شكّ . يقول المحدّث الكاشاني - الذي هو أحد المتّهمين للكليني بالقول بالتحريف والنقصان - :
ص: 288
إنّ بعض المحذوفات - التي سقطت من القرآن - كان من قبيل التفسير والبيان ، ولم يكن من أجزاء القرآن ، فيكون التبديل من حيث المعنى ، أي حرّفوه وغيّروه في تفسيره وتأويله ، أعني حملوه على خلاف ما هو به(1) .
ويستدلّ بما رواه الكافي من كلام الإمام أبي جعفر في رسالته لسعد الخير ، وبهذا قال علماء الشيعة(2) .
2 . قراءات نُسبت إلى بعض الأئمّة عليهم السلام عن طريق الآحاد ، وربما كانت تخالف قراءة الجمهور، منها ما رواه الكليني بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قرأ قوله تعالى : «هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ»(3) ، قرأها « يُنطَق » بالبناء للمفعول ، والقراءة المشهورة أنّها مبنية للفاعل ، وقد وجّه عليه السلام هذه القراءة بقوله :
إنّ الكتاب لم ينطق ولن ينطق ، ولكنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله هو الناطق بالكتاب... قال: هكذا واللّه نزل به جبرئيل على محمّد صلى الله عليه و آله ولكنّه ممّا حرّف من كتاب اللّه (4) .
ومنها : ما روي عن الإمام أنّه قرأ : «كنتم خير أئمّة أُخرجت للناس(5)» في «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ»(6) ، و «وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا»(7) في «وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»(8) ، و هذا كلّه بخلاف قراءة المصحف .
وقد أجاب الشيخ المفيد على ذلك بقوله :
ص: 289
إنّ هذه الأخبار التي جاءت بذلك ، أخبار آحاد ، لا يُقطع على اللّه تعالى بصحّتها ، فلذلك وقفنا فيها ، ولم نعدل عمّا في المصحف الظاهر على ما أُمرنا به حسبما بيّناه ،
مع أنّه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلين ، أحدهما ما تضمّنه المصحف ، والآخر ما جاء به الخبر ، كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوهٍ شتّى . . . (1) .
وهنا يسقط الاستدلال بهذه الأحاديث على وجود تحريف ؛ أوّلاً كون طريقها آحاد ، وإن كانت موافقة لبعض القراءات المعتبرة أو الشاذّة ، ومعلوم أن لا حجّية فيها ؛ لأنّ ثبوت القرآن لا يكون إلاّ بالتواتر لا بالآحاد ، وأنّ اختلاف القراءة ليس دليلاً
على الاختلاف في نصّ الوحي ، فالقراءة شيء والقرآن شيء آخر ، فلا يقوم هذا دليل على القول بالتحريف(2) .
وهذه المقدّمة تقول بعدم وجود معارض لتلك الروايات بحيث يترجّح عليها حسب نظر صاحب الكتاب ، وثبوت هذه المقدّمة في كتابٍ ما دليل على قوله واعتقاده بما رواه - على افتراض أنّ ما رواه هو ممّا يشتمل على معنى التحريف بالمعنى المتنازع فيه - ، ولكنّ الباحث المتفحّص يجد في كتاب الكافي روايات معارضة للمعنى المزعوم في هذه الروايات ، وهي « أكثر عددا وأقوى متنا ، ووردت تحت عناوين أكثر وضوحا حول القرآن من تلك »(3) .
الروايات التي زعموا أنّها تفصح عن وجود التحريف ، وهذا ما نجده في أكثر من باب في الكافي ، منه باب « فضل حامل القرآن » ، وباب « مَن يتعلّم القرآن بمشقّة » ، وباب « قراءة القرآن في المصحف » ، وباب « البيوت التي يُقرأ فيها القرآن » ، وغيرها
ص: 290
من أبواب كتاب « فضل القرآن » في كتاب الكافي(1) .
وهذه الأحاديث بجملتها تدلّ دلالة واضحة على أنّ القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن المنزل بلفظه ، لم يحدث فيه تحريف ولا تبديل لفظا ، وإلاّ لما لزم أن يحثّنا المعصومون على فضل القرآن وفضل من يقرأه ويلازم قراءته .
فضلاً عن القاعدة التي انتهجها الكليني متبعا سنّة المعصومين عليهم السلام ، وهي عرض الروايات المتعارضة على القرآن الكريم حين لا يوجد لها محمل صحيح ، فنأخذ بما وافق كتاب اللّه ونذر ما خالفه ، وهذا ما أوضحناه في موضع سابق ، لذا يكون الكليني ملتزم بقاعدة عرض الروايات المتعارضة على القرآن ، وعلى هذا تكون الروايات الدالّة على التحريف - إن وجدت - ساقطة عنده عن الحجّية(2) ، لذا لم يكن لزاما عليه أن يردّ ويقدح في كتابه هذا ؛ كونه كتاب رواية ، جمع روايات وأحاديث أهل البيت ، وليس كتابا في الدراية، فضلاً عن عدم وجود دليل على روايته نصوص تدلّ على معنى التحريف اللفظي للقرآن .
وكذلك وردت روايات صريحة عن أهل البيت عليهم السلام تأمر بقراءة هذا القرآن الذي بين أيدينا . منها : ما رواه الكليني بإسناده إلى سفيان بن السمط قال :
سألت الصادق عليه السلام عن تنزيل القرآن ؟ قال : اقرؤوا كما عُلمتم(3) .
ومن الروايات المعارضة للقول بوجود نقص في النصّ القرآني بإسقاط أسماء المعصومين عليهم السلام من القرآن ، ما رواه بإسناده عن أبي بصير :
سألت أبا عبد اللّه عن قوله تعالى : «أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ»(4) ، قال : نزلت في علي والحسن والحسين . قلت : إنّ الناس يقولون : فما باله
ص: 291
لم يسمّ عليّا وأهل بيته في كتاب اللّه ؟ قال : فقولوا لهم : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ له ثلاثا ولا أربعا ، حتّى كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله الذي فسّر لهم ذلك(1) .
والإمام يحتجّ بأُسلوب القرآن الكريم وإعجازه ، فالنصّ القرآني ورد مجملاً في كثير من آياته ، وكانت مهمّة الرسول صلى الله عليه و آله تبيينيّة لما أُبهم من النصّ ، فضلاً عن مهمّته التبليغية .
وقد عقب السيّد الخوئي قدس سره على قول الإمام عليه السلام بقوله :
هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات ، وموضّحة للمراد منها ؛ أي أنّ ذكرهم عليهم السلام إنّما كان بالنعوت والأوصاف لا بالتسمية المتعارفة(2) .
وقد ردّ الإمام الخميني قدس سره على مَن احتجّ بهذه الروايات على إثبات التحريف في النصّ القرآني بقوله :
لو كان الأمر كذلك - أي كون الكتاب الإلهي مشحونا بذكر أهل البيت وفضلهم وذكر أمير المؤمنين وإثبات وصايته وإمامته بالتسمية - فلِمَ لم يحتجّ أمير المؤمنين أو من تبعه بواحدة من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي ؟ واكتفى بالتشبّث بالأحاديث النبويّة والقرآن بين أظهرهم(3) .
وهذا كلّه لا يقوم دليلاً على قول الشيخ بالتحريف ، على افتراض أنّ هناك روايات تقول بالتحريف بالمعنى المتنازع فيه ، فما بالك وأنّ دلالة هذه الروايات لا تمسّ التحريف البتة .
من التتبّع الاستدلالي للنصوص والأدلّة التي قال بها المتّهمون للشيخ الكليني بالقول بتحريف النصّ القرآني ، وصلت الباحثة إلى قناعة تامّة بأنّ الكليني - شأنه شأن
ص: 292
معاصريه من أعلام الطائفة ومن تلاهم - لم يعتقد بالتحريف في النصّ القرآني ولم يقل به ، وأنّ الأدلّة التي استدلّ بها الذين يزعمون هذا ، تتهافت أمام النقد والتمحيص ؛ لجملة أُمور :
1 - إنّ الشيخ الكليني لم يصرّح أو يلمّح في أيّ موضعٍ من كتابه بأنّه يثقّ بكلّ ما رواه ، ولم يدّعِ أنّ كتابه صحيح كما ادّعى غيره ، وبهذا لم يكن ملزما بالقول والاعتقاد بكلّ ما يروي ، هذا إن فرضنا أنّه روى روايات تدلّ على التحريف بالمعنى المتنازع فيه . وبهذا يصدق عليه مقولة : « إنّ نقل الروايات لا تدلّ على اعتقاد ناقلها بها » .
2 - إنّ الروايات التي نقلها الكليني في كتابه على اختلاف أقسامها إن دلّت على معنى التحريف فهي تدلّ على معناه المتعارف في عصره ، وهو تغيير المعنى وسوء تأويله ، لا بمعنى التحريف اللفظي ، فهي إمّا أن تكون روايات تفسيرية ، أو تبيين مصداق خاصّ لآية عامّة قد تنطبق على عدّة مصاديق ، أو أنّها قراءات ، وأنّ هذه الروايات ممّا تحتمل توجيها صحيحا . فعدم ظهور تلك الأحاديث في التحريف ظهورا بيّنا ، وكونها ممّا يحتمل تأويلاً أو محامل أُخر غير التحريف ، يجعل المقدّمة الثانية تتهافت ولا تصمد ؛ لأنّنا لا يجوز أن نحاكمه إلاّ بمفاهيم عصره .
3 - إنّ وجود روايات معارضة لتلك الروايات التي زعموا أنّها نصّ في التحريف ، يمنع من القول بأنّها أُريد منها التحريف بالمعنى المتنازع فيه ، ودليل على عدم قوله بالتحريف ؛ لأنّه حينئذٍ يكون ناقلاً لروايات ليست من التحريف بشيء . ولا يضرّ مع هذا تصريحه أو عدم تصريحه بأنّه يثقّ بكلّ رواياته .
4 - لم يكن كتاب الكليني كتابا في دراية الحديث ، بل كان في جمع الروايات المتناثرة عن أهل البيت عليهم السلام ، وقد اعتذر في بداية كتابه أنّه أراد النصيحة لأبناء ملّته ، فإن قَصّرَ في شيء فهذا من سمات البشر .
5 - لقد ألزم نفسه بقاعدة اقتدى بها بأئمّته المعصومين إذا وردت روايات متعارضة ، وهذه القاعدة هي عرض الروايات على القرآن الكريم ، فما وافقه أخذ به ،
ص: 293
وما خالفه ساقط عنده عن الحجّية . وبهذا جعل من القرآن مقياسا صحيحا وميزانا تُقاس عليه الأحاديث لا العكس . ومن يجعل القرآن ميزانه ، محال أن يقول بتحريفه ؛ لانتفاء الغاية من القياس عليه .
من هنا نصل أنّ الكليني لم يكن من القائلين بتطرّق التحريف للنصّ القرآني ، وأنّه إن كان يثقّ بكلّ ما رواه ؛ فلأنّ ما رواه لم يكن من التحريف اللفظي في شيء .
ص: 294
1 . آلاء الرحمن ( أنوار الهداية في تفسير القرآن ) ، البلاغي النجفي ( ت 1352 ه ) ، قمّ : مكتبة الوجداني .
2 . الإتقان ، جلال الدين السيوطي ( ت 911 ه ) ، بيروت : دار ابن كثير .
3 . اعتقادات الإمامية ( الشيخ الصدوق )، محمّد بن علي بن بابويه القمّي ( ت 381 ه ) ، طبعة حجرية .
4 . أوائل المقالات ، الشيخ المفيد ، تبريز ، مكتبة الحقيقة ، 1371 ه .
5 . البرهان ، الميرزا مهدي البروجردي ، قمّ ، 1373 ه .
6 . البيان فى تفسير القرآن ، السيّد أبو القاسم الخوئي ( ت 1314 ه ) : النجف: مطبعة الآداب.
7 . تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق : عبد الوهّاب عبد اللطيف ، الرياض : مكتبة الرياض الحديثة .
8 . تفسير الصافي ، الفيض الكاشاني ، بيروت : مؤسّسة الأعلمي ، 1974م .
9 . الدُرّ المنثور في التفسير المأثور ، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 ه ) ، بيروت : دار الفكر ، 1403 ه .
10 . سلامة القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات على الشيعة الإمامية ، فتح اللّه المحمّدي ، إيران ، 1378 ه .
11 . صحيح البخاري ، أبو عبداللّه محمّد بن إسماعيل البخاري (ت 256 ق ) ، مكتبة عبد الحنيد أحمد، 1314 م .
12 . فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه ) ، بيروت : دار إحياء التراث .
ص: 295
13 . الكافي ، أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329 ه ) ، طهران : دار الكتب الإسلامية ، 1406 ه .
14 . الكشّاف، الزمخشري (538 ه )، تحقيق: عبد الرزّاق المهدي، بيروت: دار إحياء التراث
العربى، الطبعة الثانيه، 2001م.
15 . لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور المصري (ت 711 ه ) ،
بيروت : دار صادر ، الطبعة الخامسة ، 1410 ه .
16 . المسائل السروية ، الشيخ المفيد ( ت 413 ه- ) ، مهر ، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ
المفيد .
17 . مسند أحمد ، أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني ( ت 241 ه ) ، تحقيق : عبد اللّه محمّد
الدرويش ، بيروت : دار الفكر ، الطبعة الثانية ، 1414 ه .
18 . منبع الحياة ، نعمة اللّه الجزائري ( ت 112 ه ) ، بيروت : مؤسّسة الأعلمي .
19 . الموطّأ ، أبو عبد اللّه مالك بن أنس الأصبحي (ت 179 ه ) ، دمشق : دار القلم ، الطبعة الاُولى ، 1413 ه - 1991م .
ص: 296
«صيانة القرآن» بين الخفاء والجلاء
حيدر المسجدي
أورد الشيخ الكليني قدس سره في كتابه «الكافي» طائفة من الروايات ادُّعي دلالتها على وقوع التحريف في الكتاب العزيز الذي هو آخر الكتب السماوية وأشرفها . وقبل نقلها والتعرّض لمعناها نطرح السؤال التالي :
المتتبّع للنصوص يرى أنّ القرآن الكريم يحظى بمنزلة رفيعة عند المسلمين ، وخصوصاً عند أهل البيت عليهم السلام ، وفي قبال ذلك يجد بعض الروايات الدالّة - بحسب النظرة الاُولى إليها - على تحريف الكتاب العزيز ، والسؤال هنا هو : هل إنّ هذه الروايات دالّة على وقوع التحريف أم لا ؟ وهل هي صحيحة أم لا ؟
وهذا البحث الذي بين يديك ، محاولة للإجابة عن هذا السؤال ، وقد جعلناه على عدّة فصول :
القرآن الكريم أهمّ كتاب إلهيّ نزل من السماء على خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد صلى الله عليه و آله ؛ ليكون معجزة لدينه الذي هو خاتم الأديان ، فكان كتاباً خالداً وسراجاً منيراً يُهتدى به في الظلمات ، وقد جعله رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله قرين عترته الطاهرة لمن رام
ص: 297
الهداية ، وذلك في آخر خطبة له حيث قال :
إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي ما إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِما : كِتابَ اللّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ، فَإِنَّ اللَّطِيفَ الخَبِيرَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقا حَتَّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوْضَ كَهاتَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ مُسَبِّحَتَيْهِ - وَلا أَقُولُ كَهاتَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ المُسَبِّحَةِ والوُسْطَى - فَتَسْبِقَ إِحْداهُما الأُخْرَى ، فَتَمَسَّكُوا بِهِما لا تَزِلُّوا وَلا تَضِلُّوا ، وَلا تَقَدَّمُوهُمْ فَتَضِلُّوا .(1)
بل إنّ السابر لروايات أهل البيت عليهم السلام يرى اهتماماً بالغاً بالقرآن الكريم في شتّى مجالات الحياة ، ومختلف جوانبها الفرديّة والاجتماعيّة ، الدينيّة والدنيوية ، العقيديّة والعمليّة ، وغيرها ؛ ولهذا خصّص الشيخ الكليني قدس سره قسماً من كتابه للأبواب المتعلّقة بالقرآن تحت عنوان : «كتاب فضل القرآن» وأورد فيه ثلاثة عشر باباً ، أولها : «باب فضل حامل القرآن» ، كما أورد البابين التاليين في كتاب الدعاء : «باب الدّعاء عند قراءَة القرآن» و «باب الدّعاء في حفظ القرآن» ، وأورد الباب التالي ضمن أبواب الصلاة «باب قراءة القرآن» ، بل نجد في الروايات الشريفة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال :
مَنْ خالَفَ كِتابَ اللّهِ وسُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله فَقَدْ كَفَرَ .(2)
وهذا ما يدلّ بوضوح على أهميّة القرآن في حياة أهل البيت عليهم السلام وفي مذهبهم ،
ومن هنا نجد اهتمام المسلمين على مدى العصور بالقرآن الكريم .
لابدّ من تحديد معنى التحريف الذي ننفيه عن الكتاب العزيز قبل الدخول في دلالة الروايات ، ليتّضح بذلك محلّ الكلام بالدقّة .
ص: 298
في لسان العرب :
الحَرْفُ في الأَصل : الطَّرَفُ والجانِبُ ، وبه سُمّي الحَرْفُ من حروف الهِجاء. وقال الزجّاج : «عَلَى حَرْفٍ» أَي على شَكّ ، قال : وحقيقته أنّه يعبد اللّه على حرف ؛ أَي على طريقة في الدين ، لا يدخُل فيه دُخُولَ متمكّن ، «فَإِنْ أَصَابَهُو خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِى» أَي إن أَصابه خِصْبٌ وكثُرَ مالُه وماشِيَتُه اطْمَأَنَّ بما أَصابه ورضِيَ بدينه، «وَ إِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ» اخْتِبارٌ بِجَدْبٍ وقِلَّة مالٍ «انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِى» أَي رجع عن دينه إلى الكفر وعِبادة الأَوْثان .
قال الأَزهري : كأَنّ الخير والخِصْب ناحية ، والضرّ والشرّ والمكروه ناحية أُخرى، فهما حرفان ، وعلى العبد أَن يعبد خالقه على حالتي السرّاء والضرّاء، ومن عبد اللّه على السرّاء وحدها دون أَن يعبده على الضرّاء - يَبْتَلِيه اللّه بها - فقد عبده على
حرف ، ومن عبده كيفما تصرّفت به الحالُ فقد عبده عبادة عبدٍ مُقِرّ بأَنّ له خالقاً يُصَرِّفُه كيف يَشاء، وأَنّه إن امتَحَنَه بالّلأْواء أَو أَنعَم عليه بالسرَّاء فهو في ذلك عادل ، أَو متفضّل غير ظالم ولا متعدّ له الخير، وبيده الخير ولا خِيرةَ للعبد عليه . وحَرَفَ عن الشيء يَحرِفُ حَرفاً وانحَرَفَ وتَحَرَّفَ وَاحرَورَفَ : عَدَلَ. وإذا مالَ الإِنسانُ عن
شيءٍ يُقال : تَحَرَّف وانحَرَفَ وَاحرَورَفَ(1) .
للتحريف الذي يدّعى وقوعه في القرآن معانٍ وصور عديدة ، هي :
1 - التحريف في القراءة .
2 - تحريف معاني القرآن .
3 - النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات .
4 - النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين .
5 - التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة .
ص: 299
6 - التحريف بالنقيصة في الآيات والسور .
7 - التحريف بالزيادة ؛ بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل .
فالاختلاف في القراءات واقع بلا ريب ، وكذا تحريف المعاني كما هو صريح بعض الروايات كقوله عليه السلام : «وَ كَانَ مِنْ نَبْذِهِمُ الكِتَابَ أَنْ أَقَامُوا حُرُوفَهُ وَ حَرَّفُوا حُدُودَهُ»(1) .
أمّا المعاني الأُخرى فقد ذكرها السيّد الخوئي قدس سره وبيّن موضع الخلاف فيها ، فاكتفينا بنقل عبارته ، قال قدس سره :
يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدة معانٍ على سبيل الاشتراك ، فبعض منها واقع في القرآن باتّفاق من المسلمين ، وبعض منها لم يقع فيه باتّفاق منهم أيضاً ، وبعض منها وقع الخلاف بينهم :
الأول : نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره ، ومنه قوله تعالى : «مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ»(2) . ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل
هذا التحريف في كتاب اللّه ، فإنّ كلّ من فسّر القرآن بغير حقيقته وحمله على غير معناه فقد حرّفه . وترى كثيراً من أهل البدع والمذاهب الفاسدة قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم . وقد ورد المنع عن التحريف بهذا المعنى ، وذمّ فاعله في عدّة من الروايات .
الثاني : النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات مع حفظ القرآن وعدم ضياعه ، وإن لم يكن متميّزاً في الخارج عن غيره . والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعاً ، فقد أثبتنا لك فيما تقدّم عدم تواتر القراءات ، ومعنى هذا أنّ القرآن المنزل إنّما هو مطابق لإحدى القراءات ، وأمّا غيرها فهو إمّا زيادة في القرآن وإمّا نقيصة فيه .
ص: 300
الثالث : النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفّظ على نفس القرآن المنزل . والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام وفي زمان الصحابة قطعاً ، ويدلّنا على ذلك إجماع المسلمين على أنّ عثمان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق كلّ مصحف غير ما جمعه ، وهذا يدلّ على أنّ هذه المصاحف كانت مخالفة لما جمعه ، وإلاّ لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها . وقد ضبط جماعة من العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف ، منهم عبد اللّه بن أبي داوود السِّجِستاني ، وقد سمّى كتابه هذا بكتاب المصاحف .
وعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة إمّا من عثمان أو من كتّاب تلك المصاحف ، ولكنّا سنبيّن بعد هذا إن شاء اللّه تعالى أنّ ما جمعه عثمان كان هو القرآن المعروف بين المسلمين ، الذي تداولوه على النبيّ صلى الله عليه و آله يداً بيد ، فالتحريف بالزيادة والنقيصة إنّما وقع في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عهد عثمان ، وأمّا القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقيصة .
الرابع : التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفّظ على القرآن المنزل ، والتسالم على قراءة النبيّ صلى الله عليه و آله إيّاها . والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في القرآن قطعاً ، فالبسملة - مثلاً - ممّا تسالم المسلمون على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قرأها قبل كلّ سورة غير سورة التوبة ، وقد وقع الخلاف في كونها من القرآن بين علماء السنّة ، فاختار جمع منهم أنّها ليست من القرآن ، وذهب آخرون إلى أنّ البسملة من القرآن . وأمّا الشيعة فهم متسالمون على جزئية البسملة من كلّ سورة غير سورة التوبة ، واختار هذا القول جماعة من علماء السنّة أيضاً .
إذن فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقيناً بالزيادة أو بالنقيصة .
الخامس : التحريف بالزيادة ؛ بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل . والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين ، بل هو ممّا علم بطلانه بالضرورة .
السادس : التحريف بالنقيصة ؛ بمعنى أنّ المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء ، فقد ضاع بعضه على الناس . والتحريف بهذا
ص: 301
المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونفاه آخرون(1) .
لا ريب أنّ ظهور اللفظ أو التركيب الوارد في الحديث في معنىً معين حجّة في ذلك المعنى ، إنّما المهمّ هو تعيين النقطة التالية : أيّ ظهور للحديث هذا الذي يعتبر حجّة ،
هل هو ظهوره في معنى معيّن في زماننا الحاضر ، أم ظهوره في معنى معيّن في زمان صدوره ؟
وبعبارة أوضح : اللغة ظاهرة اجتماعية تتغيّر شيئاً فشيئاً حتّى أنّ لكلّ فترة أدب خاصّ ، فإذا كان المفهوم من هذا اللفظ أو التركيب معنىً معيّناً في زمان صدوره ، وتغيّر مدلوله شيئاً فشيئاً حتّى صار معناه شيئاً آخر ، فإذا أردنا فهم هذا الحديث ، فأيّ هذين المعنيين هو الحجّة علينا شرعاً ، وأيّهما هو مراد النبي صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام ؟
لا شكّ ولا ريب أنّ المعنى الصحيح للحديث هو ما كان ظاهراً منه وفقا للقرائن المختلفة الحافّة به في عصر صدوره ، من ثقافة ذلك المجتمع ، وأساليب التعبير المستعملة في تلك الفترة ، وكلّ ما له دخل في تحقيق وتشكيل المعنى .
وهذه النقطة من النقاط الأساسيّة في البحث ، إذ إنّ أساس شبهة التحريف هو الخلط في هذه النقطة ، وتصوّر أنّ المعنى الظاهر من الكلام - والذي هو حجّة - هو المعنى الظاهر منه في عصرنا الحاضر .
قبل الدخول في البحث من الضروري التنبيه على أنّ فهم نصوص الكتاب العزيز والحديث الشريف فهماً صحيحاً يتوقّف على مراعاة جملة أُمور ، نشير إلى أهمّها بشكل مقتضب وبقدر الضرورة :
ص: 302
أ - الاعتماد على القرائن : كلّ متكلّم عاقل حكيم يعتمد في كلامه - لبيان مراده ومقصوده - على القرائن المختلفة - الحاليّة والسياقيّة - والمرتكزات العرفيّة وغيرها ، فإنّ كلّ قرينة من القرائن المختلفة تقوم مقام عبارة أو عبارات متعدّدة لبيان المقصود من الكلام ، فمثلاً في العراق إذا قيل للسائل : «أعطاك اللّه» فهم منها : «اِنصرف» ، ولم يفهم منها الدعاء له ، مع أنّه لا دلالة في ألفاظ التركيب المذكور على هذا المعنى . وأمّا إذا قيل ذلك لرجل وقع في شدّة مالية ولم يسأل الآخرين شيئاً فإنّ المفهوم من العبارة المذكورة هو الدعاء لا غير ، وهذا الفرق في المعنى - مع اتّحاد العبارة - إنّما نشأ من القرائن المكتنفة للكلام .
والاعتماد على القرائن في المحاورات أمر رائج في جميع المجتمعات ، وفي جميع اللُّغات ، ولا يختصّ باللُّغة العربيّة ، بل إنّ العرف قد يستهجن ذكر تفاصيل كلّ شيء إذا أمكن الاستغناء عن بعض تلك التفاصيل بالاعتماد على القرائن المختلفة .
ومن الواضح أنّ أهل البيت عليهم السلام الذين هم أفصح الناس وأبلغهم ، كانوا يعتمدون الأساليب المتعارفة بين العقلاء ويتّبعون العرف السائد في التفاهم والتحاور ، فكانوا يعتمدون على القرائن باختلاف أنواعها في بيان ما يريدون . فلابدّ - والحال هذه - من التعرّف على القرائن المحيطة بكلام المعصوم عليه السلام لفهمه بشكل صحيح .
ب - ضياع القرائن : لا شكّ ولا ريب أنّ جملة من القرائن المحيطة والمكتنفة بالحديث - والتي لها دور مؤثّر في فهمه ، ومن جملتها بل من أهمّها المرتكزات العرفيّة - قد ضاعت خلال نقل الحديث عبر السنين المتطاولة والقرون المتمادية ، فالقرائن الارتكازية غالباً ما تقع الغفلة عنها عند النقل ؛ لاعتماد الراوي على وضوحها لدى المخاطب(1) ، وبمرور الزمان وتغيّر الظروف تندرس هذه القرائن ، فيبقى الكلام
ص: 303
عارياً عنها ، ممّا يجعله ظاهراً في معنى آخر غير مقصود للمعصوم أو المتكلّم أصلاً ، أو يجعله مبهماً غير مفهوم .
ولكن هل هذا يعني لزوم طرح النصوص المذكورة ، أم أنّه يمكن تحصيل هذه القرائن بعد بذل الجهد والتتبّع الكثير ؟
لا ريب أنّ جملة من القرائن المؤثّرة على فهم الحديث تبقى محفوظة في متن التاريخ بأشكال مختلفة ، سواء كانت ثقافية أم اجتماعية أم سياسية أم غيرها ، فتتبّعها له أثر إيجابي في فهم النصوص بلا ريب . نعم ، قد لا نحصل على القرائن المطلوبة في جميع الأحوال .
ج - فهم أصحاب الأئمّة عليهم السلام : من جملة الأُمور التي يمكن الاعتماد عليها كقرينة لفهم الحديث - مع وجود هذا الفاصل الزمني الطويل بيننا وبين زمان صدور الحديث - هو فهم أصحاب الأئمّة عليهم السلام وخواصّهم والعلماء الذين كانوا في تلك الفترات وما قاربها ، فإذا عثرنا على قرائن تدلّ على فهم الطبقة المعاصرة للأئمّة عليهم السلام - أو المقاربين لهم - لحديث معيّن أو مجموعة من الأحاديث فهماً معيّناً ، كان هذا الفهم قرينة مهمّة لتعيين المراد من النصوص التي نريد فهمها ؛ وذلك أنّ هؤلاء كانوا يعيشون في تلك الأجواء ، وتلك الثقافة ، وتلك الأعراف ، ممّا يجعل فهمهم نابعاً من نفس تلك القرائن التي اعتمدها المعصومون عليهم السلام .
وبعد هذه المقدّمة نتعرّض لسرد الروايات المروية في الكافي ، والمدّعى دلالتها على التحريف ، لمعرفة المقصود منها بحسب القرائن الموجودة ، وبالتالي معرفة صحّة أو سقم هذه الدعوى .
الروايات التي رواها الشيخ الكليني قدس سره في الكافي - والتي ادُّعي دلالتها على التحريف - كثيرة ، فلأجل استيفاء البحث فيها قسّمناها إلى طوائف كالتالي :
ص: 304
الروايات التي وردت بين ألفاظ آياتها بعض الكلمات أو العبارات التي ليست هي من الآية ، نظير الروايات التالية :
1 - عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خالِدٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي طالِبٍ عَن يُونُسَ عن بَكَّارٍ عَن أَبِيهِ عَن جابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ عليه السلام : «وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ» فِي عَلِيٍّ «لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ»(1) .(2)
2 - عَلِيُّ بنُ إِبراهِيمَ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ البَرقِيِّ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ الفُضَيلِ عَن أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ عليه السلام فِي قَولِهِ تَعالَى : «هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فِى رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ»بِوَلايَةِ عَلِيٍّ «قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ»(3) .(4)»
الروايات التي وردت فيها بعض ألفاظ الآية بمعناها لا بلفظها الموجود في المصحف ، نظير الروايات التالية :
1 - الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن مُعَلَّى بنِ مُحَمَّدٍ عَن أَحمَدَ بنِ النَّضرِ عَن مُحَمَّدِ بنِ مَروانَ
رَفَعَهُ إِلَيهِم فِي قَولِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ»(5) فِي عَلِيٍّ وَ الأَئِمَّةِ كالَّذِينَ آذَوا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللّهُ مِمّا قالُوا(6) .(7)
2 - أَحمَدُ بنُ إِدرِيسَ عَن مُحَمَّدِ بنِ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ عَن عَمَّارِ بنِ مَروانَ
ص: 305
عَن مُنَخَّلٍ عَن جابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ عليه السلام قالَ : «أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ» مُحَمَّدٌ(1)«بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ» بِمُوالاةِ عَلِيٍّ فَ- «اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا» مِن آلِ مُحَمَّدٍ «كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ»(2) .(3)
3 - مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى عَن سَلَمَةَ بنِ الخَطَّابِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَولِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَىُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا»(4) قالَ : كانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله دَعا قُرَيشاً إِلَى وَلايَتِنا فَنَفَرُوا وأَنكَرُوا ، فَ-«-قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ »مِن قُرَيشٍ «لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ» الَّذِينَ أَقَرُّوا لأمِيرِ المُؤمِنِينَ ولَنا أَهلَ البَيتِ «أَىُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا»تَعيِيراً مِنهُم . فَقالَ اللّهُ رَدّاً عَلَيهِم : «كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ» مِنَ الأُمَمِ السَّالِفَةِ «هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا»(5) . قُلتُ : قَولُهُ : «مَن كَانَ فِى الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدًّا»(6) قالَ :
كُلُّهُم كانُوا فِي الضَّلالَةِ لا يُؤمِنُونَ بِوَلايَةِ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عليه السلام وَ لا بِوَلايَتِنا فَكانُوا ضالِّينَ مُضِلِّينَ فَيَمُدُّ لَهُم فِي ضَلالَتِهِم وَ طُغيانِهِم حَتَّى يَمُوتُوا فَيُصَيِّرُهُمُ اللّهُ شَرّاً مَكاناً وَ أَضعَفَ جُنداً(7) ... .(8)
الروايات التي ورد فيها عبارات أو كلمات بعد فقرات الآية ، وورد فيها أنّ الآية هكذا
ص: 306
نزلت ، نظير الروايتين التاليتين :
1 - الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن مُعَلَّى بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلِيِّ بنِ أَسباطٍ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَولِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُو» فِي وَلايَةِ عَلِيٍّ وَ وَلايَةِ الأَئِمَّةِ مِن بَعدِهِ «فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا»(1) هكَذا نَزَلَت .(2)
2 - الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن مُعَلَّى بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلِيِّ بنِ أَسباطٍ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي حَمزَةَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَولِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ»(3) يا مَعشَرَ المُكَذِّبِينَ حَيثُ أَنبَأتُكُم رِسَالَةَ رَبِّي فِي وَلايَةِ عَلِيٍّ عليه السلام وَ الأَئِمَّةِ عليهم السلام مِن بَعدِهِ «مَنْ هُوَ فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ» كَذا أُنزِلَت ... .(4)
الروايات التي قُرئت فيها الآية بنحو يختلف عن القراءة المعروفة ، نظير الروايتين التاليتين :
1 - أَحمَدُ عَن عَبدِ العَظِيمِ عَنِ الحُسَينِ بنِ مَيَّاحٍ عَمَّن أَخبَرَهُ قالَ قَرَأَ رَجُلٌ عِندَ أَبِي عَبدِ اللّهِ عليه السلام ِ «وَ قُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُو وَ الْمُؤْمِنُونَ»(5) فَقالَ : لَيسَ هكَذا هِيَ ، إِنَّما هِيَ «وَ المَأمُونُونَ» فَنَحنُ المَأمُونُونَ .(6)
2 - أَحمَدُ عَن عَبدِ العَظِيمِ عَن هِشامِ بنِ الحَكَمِ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عليه السلام قالَ : «هَذَا صِرَ طٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ»(7) .(8)
ص: 307
الروايات التي ورد فيها عنوان تحريف كتاب اللّه ، وهي رواية واحدة :
1 - سَهلُ بنُ زِيادٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ سُلَيمانَ الدَّيلَمِيِّ المِصرِيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أَبِي عَبدِ اللّهِ عليه السلام قالَ : قُلتُ لَهُ : قَولُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ» قالَ : فَقالَ : إِنَّ الكِتابَ لَم يَنطِق وَ لَن يَنطِقَ وَ لكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله هُوَ النَّاطِقُ بِالكِتابِ ، قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ» قالَ : قُلتُ : جُعِلتُ فِداكَ إِنَّا لا نَقرَؤها هكَذا ؟ فَقالَ : هكَذا و اللّهِ نَزَلَ بِهِ جَبرَئِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله وَ لكِنَّهُ فِيما حُرِّفَ مِن كِتابِ اللّهِ .(1)
الروايات التي ورد فيها أنّ القرآن نزل أثلاثاً أو أرباعاً ، ثلث منه أو ربع منه في ولاية أهل البيت عليهم السلام ، نظير الروايتين التاليتين :
1 - عِدَّةٌ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ عَنْ أبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبِي حَمْزَةَ عَنْ أبِي يَحْيَى عَنِ الأصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أمِيرَ المُؤمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ : نَزَلَ القُرْآنُ أثْلاثاً : ثُلُثٌ فِينَا وَفِي عَدُوِّنَا ، وَثُلُثٌ سُنَنٌ وَأمْثَالٌ ، وَثُلُثٌ فَرائِضُ وَأحْكَامٌ(2) .
2 - عِدَّةٌ مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ داوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام قَالَ : إِنَّ القُرْآنَ نَزَلَ أرْبَعَةَ أرْبَاعٍ : رُبُعٌ حَلالٌ ، وَرُبُعٌ حَرامٌ ، وَرُبُعٌ سُنَنٌ وأحْكَامٌ ، وَرُبُعٌ خَبَرُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَنَبَأُ مَا يَكُونُ بَعْدَكُمْ وَفَصْلُ مَا بَيْنِكُمْ(3) .
ص: 308
الروايات التي ورد فيها زيادة في بعض حروف الآية ، نظير الرواية التالية :
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : مَا قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ العَقْلِ ، فَنَوْمُ العَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَهَرِ الجَاهِلِ ، وَ إِقَامَةُ العَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الجَاهِلِ ، وَ لا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً وَ لا رَسُولاً حَتَّى يَسْتَكْمِلَ العَقْلَ ، وَ يَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ . وَ مَا يُضْمِرُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله فِي نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنِ اجْتِهَادِ المُجْتَهِدِينَ ، وَ مَا أَدَّى العَبْدُ فَرائِضَ اللَّهِ حَتَّى عَقَلَ عَنْهُ ، وَ لا بَلَغَ جَمِيعُ العَابِدِينَ فِي فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ العَاقِلُ وَ العُقَلاءُ ، هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَ مَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ(1) .(2)
والجدير بالذكر ، أنّ البحث الموضوعي في أمثال هذه الروايات يجب أن يتّسم بما يلي :
1 - أن يكون الوجه المذكور لفهم الروايات ممّا لا يأباه الفهم العرفي .
2 - أن يكون منسجما مع القرائن الموجودة والواصلة إلينا .
3 - أن ينسجم مع الروايات والقرائن الحافّة بها .
4 - أن يكون هو الاحتمال المتعيّن من بين الاحتمالات ، أو على الأقلّ أن يكون الاحتمال الأرجح من بين الاحتمالات ، لا أن يكون كغيره أو أضعف من غيره . وعليه فيجب إبداء الاحتمالات المختلفة أوّلاً ، ثمّ دراسة كلّ منها .
إنّ الاحتمالات التي يمكن تصوّرها في هذه الروايات هي :
1 - أن تكون هذه الروايات موضوعة ولا أساس لها .
2 - أن يكون المقصود منها هو إثبات وقوع تحريف القرآن الكريم بنقص بعض
ص: 309
ألفاظه .
3 - أن يراد بها التفسير وبيان أحد وجوه الآيات الكريمة .
وإليك تقييم كلّ احتمال منها :
ليس في متون الروايات المذكورة ما يدعو إلى القول بجعلها وبأنّها موضوعة ، سوى ظهورها الأوّلي في التحريف ، لكنّ التحريف غير موافق وغير منسجم مع روح الروايات الأُخرى الدالّة على الاهتمام بالقرآن ، والتي سيأتي الإشارة إليها في الاحتمال اللاّحق .
وعلى هذا ، فالأساس والركيزة التي يبتني عليها هذا الاحتمال هي : إنّ المراد من هذه الأحاديث هو إثبات تحريف القرآن ، وذلك بحذف بعض ألفاظه وتغيير البعض الآخر منها ، وأمّا من دون دلالتها على التحريف فلا موجب للقول بجعلها ووضعها . وبهذا يرجع هذا الاحتمال في أساسه إلى الاحتمال اللاّحق . أو فقل : إنّ هذا الاحتمال من فروع الاحتمال اللاحق ، فإذا أمكن إثبات أنّ المراد بهذه الروايات هو التحريف ، كان للبحث في هذا الاحتمال مجال ، وإلاّ فلا .
وبعبارة أوضح : لأجل البحث في هذا الاحتمال يجب أوّلاً إحراز أنّ المراد من هذه الأحاديث هو إثبات وقوع التحريف في ألفاظ القرآن ، إذ مجرّد احتمال ذلك لا يسوّغ الحكم عليها بالوضع ، لعدم وجود ما يدلّ عليه .
علماً أنّ الحكم بالوضع على رواية واحدة أو عدد قليل منها قد يكون سهلاً ، وأمّا الحكم بالوضع على هذا العدد من الروايات - خصوصاً مع ورودها في كتاب معتبر وهو «الكافي» - فهو في غاية الصعوبة ، ما لم تدلّ عليه الشواهد وتشهد له القرائن الأُخرى .
نعم قد يقال بوضع بعضها لدلالة بعض القرائن الأُخرى ؛ ككون الراوي من
ص: 310
الوضّاعين والمشهورين بالوضع ، أو عن طريق وجود قرائن أُخرى تساعد عليه .
هذا الاحتمال أهمّ الاحتمالات ، ولأجله عقدنا هذا البحث ، بل لعلّه المتعيّن من بين الاحتمالات لأوّل وهلة ؛ فالذي يراجع الروايات المذكورة يجد في بعضها التعابير التالية :
- «هكَذا نَزَلَت»(1) .
- «هكَذا و اللّهِ نَزَلَت عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله »(2) .
- «هكَذا وَ اللّهِ نَزَلَ بِها جَبرَئِيلُ عليه السلام عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله »(3) .
- «هُوَ قَولُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جَبرَئِيلُ عليه السلام عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله »(4) .
ولعلّ هذه التعابير ونحوها هي المنشأ لتصوّر إرادة التحريف من هذه الروايات ، من دون ملاحظة ملابساتها والقرائن التي يمكن أن تؤثّر في فهمها .
وقد تقدّم أنّ الأساس الذي يعتمد عليه القول بالتحريف هو الاشتباه في هذه النقطة ، وتصوّر أنّ المعنى المتبادر من هذه الروايات هذا اليوم ، والذي لا يؤخذ فيه بنظر الاعتبار القرائن المحيطة بالكلام حين صدوره . وتقدّم أنّ المنهج الصحيح في فهم الروايات هو فهمها من خلال الأخذ بنظر الاعتبار القرائن المحيطة بها . فالاعتماد على ما يُفهم منها في عصرنا الحاضر مع قطع النظر عن القرائن المذكورة ليس صحيحاً .
أمّا ما يمكن أن ينفي هذا الاحتمال فهو :
ص: 311
لا ريب أنّ للمسلمين اهتماما شديدا بالقرآن الكريم على مدى العصور ، من زمن النبيّ صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا ، فإذا كانت الروايات المذكورة قد سيقت للدلالة على حذف فقرات من الآي الحكيم لكان مثاراً للكلام والتعجُّب والضجّة بين المسلمين في زمان المعصومين عليهم السلامالذين نطقوا بذلك ، مع أنّنا لا نجد لذلك عينا ولا أثراً في التاريخ والروايات . بل لا نجد اعتراضاً على الأئمّة عليهم السلام في ذلك .
نعم نجد في بعض الروايات تعجّب السامع من قراءة أهل البيت عليهم السلام ، فروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
قُلتُ لَهُ : قَولُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ» قالَ فَقالَ : إِنَّ الكِتابَ لَم يَنطِق وَ لَن يَنطِقَ وَ لكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله هُوَ النَّاطِقُ بِالكِتابِ ؛ قالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ : «هَذَا كِتَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ» . قالَ : قُلتُ : جُعِلتُ فِداكَ ، إِنَّا لا نَقرَؤها هكَذا ؟ فَقالَ : هكَذا و اللّهِ نَزَلَ بِهِ جَبرَئِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ، وَ لكِنَّهُ فِيما حُرِّفَ مِن كِتابِ اللّهِ .(1)
وهي في اختلاف القراءات كما هو واضح ، لا في حذف شيء من القرآن ، واختلاف قراءة القرآن ثابتة بلا ريب كما تقدّم .
والنقطة الجديرة بتسليط الأضواء عليها هي : إنّنا نجد تعجّب الراوي واستغرابه من هذه القراءة ، واعتراضه على الإمام عليه السلام ، فهل يعقل أن يكون المراد من هذا العدد الكثير من الروايات هو التحريف بحذف فقرات من آي الذكر الحكيم وهذا الحذف بمسمع من المسلمين ، ومع ذلك لا نجد اعتراضاً من أحدهم في شيء من الروايات ! هذا غير معقول إطلاقاً .
فهذه قرينة على عدم فهم أصحاب الأئمّة عليهم السلام ومعاصريهم التحريفَ من هذه الروايات ، وهي القرينة الاُولى النافية لإرادة التحريف من هذه الروايات .
ص: 312
من الأُمور التي ينبغي ملاحظتها عند فهم الحديث وتقييمه والتعامل معه هو لحاظ الروايات الأُخرى ؛ فإن الروايات كالبنيان المرصوص الذي يشدّ بعضه بعضاً ، فبعضها يبيّن بعضاً . وهذا لا يختصّ بالروايات الشريفة ، بل هو أُسلوب متعارف في عرف أهل القانون في جميع البلدان ، فإذا اعتمد الفرد في فهمه لقانون معين على مادة قانونية من دون الأخذ بنظر الاعتبار القوانين الأُخرى فإنّه سيفهمه فهماً خاطئاً بلا ريب ، فإن القوانين يفسّر بعضها بعضاً ، فالقانون الذي يثبت حرّية إبداء الرأي لأفراد المجتمع لابدّ أن يفهم بما ينسجم مع القوانين الأُخرى ؛ من عدم التعدّي على حقوق الآخرين ، وعدم المسّ بالمقدّسات ، و ... ، فإذا مسّ أحد الأفراد كرامة النبيّ صلى الله عليه و آله أو أحد المعصومين عليهم السلاممحتجّاً بحرّية الرأي فلا يعذر في ذلك بلا ريب . وكذا الروايات ، فإنّ فهمها الصحيح يكون من خلال النظر إلى الروايات الأُخرى ، ومع مراعاة الانسجام بينها .
والذي يراجع الروايات والنصوص الإسلاميّة يجد بوضوح أنّها لا تنسجم مع دعوى التحريف ؛ فإنّنا نجد في الروايات والنصوص الإسلاميّة اهتماماً بالغاً بالقرآن ، وقد تقدّمت الإشارة إلى الأبواب التي عقدها الشيخ الكليني قدس سره في كتابه الكافي ، بل هناك روايات كثيرة أُخرى في غير الكافي أيضاً منها ما رواه الشيخ المجلسي قدس سره في كتابه بحار الأنوار ضمن أبواب «كتاب القرآن»(1) ، وهي أبواب متنوّعة ، وتتضمن روايات كثيرة جداً ، وهذا ما يبيّن اهتمام الأئمّة عليهم السلامبالقرآن الكريم ، وهو لا ينسجم مع دلالة هذه الروايات على التحريف بلا ريب ؛ إذ لو كان محرّفاً لما وقع هذا الحثّ الأكيد على قراءته وحمله وحفظه و ... خصوصاً مع ورود الروايات بهذا العدد الملفت للانتباه .
ص: 313
بل نجد في أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجّادية دعاءه عند ختم القرآن :
اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَنِي عَلَى خَتْمِ كِتابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ نُوراً ، وَ جَعَلْتَهُ مُهَيْمِناً عَلى كُلِّ كِتابٍ أَنْزَلْتَهُ ، وَ فَضَّلْتَهُ عَلى كُلِّ حَدِيثٍ قَصَصْتَهُ ، وَ فُرْقاناً فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلالِكَ وَحَرامِكَ، وَ قُرْآناً أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرائِعِ أَحْكامِكَ ، وَ كِتاباً فَصَّلْتَهُ لِعِبادِكَ تَفْصِيلاً ، وَ وَحْياً أَنْزَلْتَهُ عَلى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَنْزِيلاً ، وَ جَعَلْتَهُ نُوراً نَهْتَدِي مِنْ ظُلَمِ الضَّلالَةِ وَ الجَهالَةِ بِاتِّبَاعِهِ، وَ شِفاءً لِمَنْ أَنْصَتَ بِفَهْمِ التَّصْدِيقِ إِلى اسْتِمَاعِهِ، وَ مِيزانَ قِسْطٍ لا يَحِيفُ عَنِ الحَقِّ لِسانُهُ، وَ نُورَ هُدًى لا يُطْفَأُ عَنِ الشَّاهِدِينَ بُرْهَانُهُ، وَ عَلَمَ نَجَاةٍ لا يَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنَّتِهِ، وَ لا تَنَالُ أَيْدِي الهَلَكاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ عِصْمَتِهِ. اللَّهُمَّ فَإِذْ أَفَدْتَنَا المَعُونَةَ عَلى تِلاوَتِهِ، وَ سَهَّلْتَ جَواسِيَ أَلْسِنَتِنَا بِحُسْنِ عِبارَتِهِ، فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَرْعَاهُ حَقَّ رِعايَتِهِ، وَ يَدِينُ لَكَ بِاعْتِقَادِ التَّسْلِيمِ لِمُحْكَمِ آياتِهِ، وَ يَفْزَعُ إِلَى الإِقْرارِ بِمُتَشَابِهِهِ، وَ مُوضَحَاتِ بَيِّناتِهِ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) مُجْمَلاً، وَ أَلْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجائِبِهِ مُكَمَّلاً، وَ وَرَّثْتَنا عِلْمَهُ مُفَسَّراً، وَ فَضَّلْتَنا عَلى مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ، وَ قَوَّيْتَنا عَلَيْهِ لِتَرْفَعَنا فَوْقَ مَنْ لَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ. اللَّهُمَّ فَكَما جَعَلْتَ قُلُوبَنا لَهُ حَمَلَةً، وَ عَرَّفْتَنا بِرَحْمَتِكَ شَرَفَهُ وَ فَضْلَهُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الخَطِيبِ بِهِ، وَ عَلى آلِهِ الخُزَّانِ لَهُ ...
.(1)
وهذا أكبر دلالة على اهتمام الأئمّة عليهم السلام البالغ بالقرآن ، حيث بيّنوا أهميّته ، والآداب المختلفة لتلاوته وختمه .
ومن جانب آخر فإنّنا نجد أئمّتنا عليهم السلام يستدلّون ويستشهدون بالآيات الكريمة في المجالات المختلفة من العقائد والفقه والأخلاق وغيرها ، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على عدم تحريف القرآن ، إذ لو كان محرّفاً لما استشهد به الأئمّة عليهم السلامفي بعض المجالات كالعقائد والفقه .
بل روى المجلسي في البحار نقلاً عن إكمال الدين وإتمام النعمة بسنده التالي : غير
ص: 314
واحد من أصحابنا ، عن محمّد بن همام ، عن عبد اللّه جعفر ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله :
إنَّ اللّهَ عَزَّوجَلَّ اختارَ مِنَ الأَيّامِ الجُمُعَةَ ، ومِنَ الشُّهورِ شَهرَ رَمَضانَ ، ومِنَ اللَّيالي لَيلَةَ القَدرِ ، وَاختارَني عَلى جَميعِ الأَنبِياءِ ، وَاختارَ مِنّي عَلِيّاً وفَضَّلَهُ عَلى جَميعِ الأَوصِياءِ ، وَاختارَ مِن عَلِيٍّ الحَسَنَ والحُسَينَ ، وَاختارَ مِنَ الحُسَينِ الأَوصِياءَ مِن وُلدِهِ ، يَنفونَ عَنِ التَّنزيلِ تَحريفَ الغالينَ ، وَانتِحالَ المُبطِلينَ ، وتَأويلَ المُضِلّينَ ، تاسِعُهُم قائِمُهُم ، وهُوَ ظاهِرُهُم وهُوَ باطِنُهُم .(1)
وهو صريح في أنّ أحد شؤون الأئمّة عليهم السلام هو المحافظة على التنزيل ب-«نفي تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل المضلّين» ، وصيانته عن التحريف .
ولهذا فإنّ الروايات المذكورة لو كانت دالّة على تحريف القرآن فهي تتنافى مع روح هذا الكمّ الهائل من الروايات ، الأمر الذي لا يمكن صدوره عن عالم ، فضلاً عن صدوره عن أهل البيت عليهم السلام ؛ الذين هم أوصياء النبيّ صلى الله عليه و آله وخلفاؤه من بعده ، وأُمناؤه في حفظ الشريعة المقدّسة ، والذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . وهذه هي القرينة الثانية النافية لإرادة التحريف من هذه الروايات .
الاحتمال المتبقّي من بين الاحتمالات المذكورة هو هذا الاحتمال ، فلابدّ من البحث عن القرائن والشواهد المثبتة أو النافية له كي ننتهي إلى المقصود من هذه الروايات ، وإليك فيما يلي بعض ما عثرنا عليه من هذه القرائن :
المجتمع الذي بعث فيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله مجتمعٌ جاهليّ تغمره عادات وأخلاق
ص: 315
الجاهليّة ؛ من العصبيّة القبليّة وغيرها ، بل فيه بعض الأخلاق التي هي في معزل عن الإنسانيّة بالمرّة ؛ كوأد البنات . فلمّا بُعِث خاتمُ الأنبياء والمرسلين - عليه صلوات المصلّين إلى يوم الدين - برسالته الخالدة التي هي خير دين ، أبان أنّ هدفه تتميم مكارم الأخلاق فقال صلى الله عليه و آله :
إنَّما بُعِثتُ لاِتَمِّمَ مَكارِمَ الأخلاقِ .(1)
وقال صلى الله عليه و آله :
أدَّبَني رَبّي فَأحسَنَ تَأديبي .(2)
فبدأ بنشر الرسالة ، وبثّ مكارم الأخلاق بين الناس ، وتحمّل ما تحمّل من الأذى في ذلك حتّى قال :
ما أُوذِيَ نَبِيٌّ مِثلَ ما أُوذيتُ .(3)
وكان من أسباب عنائه صلى الله عليه و آله في تبليغ الرسالة هو سوء أخلاق المجتمع الذي كان فيه ، والعادات الحاكمة عليه ، حيث كان يحاول تغييره وإصلاحه ، فيأبون ذلك ، ومن الواضح أنّ تغيير مجتمع بهذه الصفة بحاجة إلى زمن طويل ، وعناء كبير ، فإنّ الموازين التي يعتمدها هذا المجتمع موازين عوجاء ؛ فيقدّم الكبير سنّاً وذو المال والجاه على غيره وإن كان مرجوحاً ، ولم يكن الترجيح على أساس المبادئ والقِيم .
ومن جانب آخر كانت العصبيّة القبليّة قد نشبت أظفارها في أبناء ذلك المجتمع ، حتّى صارت القبيلة إلهاً يُعبد من دون اللّه ، وعادت معياراً لتقييم الحقّ من الباطل ، ولهذا نجدهم ينصرون أبناء قبيلتهم وعشيرتهم على الآخرين عند وقوع نزاع أو خلاف ، سواء كانوا في جانب الحقّ أم في جانب الباطل ، بل نجدهم يرجعون في
ص: 316
حلّ النزاعات وتعيين حقوق الأفراد إلى رئيس العشيرة لا إلى العلماء ، كما نجده اليوم في بعض المناطق .
والتاريخ يشهد في جملة من الموارد بعدم انصياع المسلمين لأمر النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ لكونه مخالفاً لهذه الأخلاق القبليّة والنزعة القوميّة ، بل إنّنا نجد آثار هذه الأخلاق في حياة
المسلمين إلى آخر أيّام حياة النبيّ صلى الله عليه و آله أيضاً ، فينقل لنا المؤرّخون والمحدّثون عدم طاعة بعض الصحابة للنبيّ حين أمر المسلمين بالخروج مع جيش أُسامة وعدم التخلّف عنه ، حتّى قال صلى الله عليه و آله :
لَعَنَ اللّهُ مَن تَخَلَّفَ عَن جَيشِ أُسامَة .(1)
لكنّ عرق القبليّة دفع البعض إلى الطعن في تأمير النبيّ صلى الله عليه و آله أُسامة ، حتّى قالوا ما قالوا ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله :
أيُّها النّاسُ ، ما مَقالَةٌ بَلَغتني عَن بَعضِكُم في تَأميري أُسامَةَ ! لَقَد طَعَنتُم في إمارَتي أباهُ مِن قَبلُ ، وأيمُ اللّهِ إنَّهُ لِلإمارَةِ لَخَليقٌ ، وابنهُ بَعدَهُ لِلإمارَةِ خَليقٌ ، وهُوَ مِن أحَبِّ النّاسِ إلَيَّ ، وإنَّهُما أهلٌ لِكُلِّ خَيرٍ فَاستَوصوا بِهِ خَيراً ؛ فَإنَّهُ مِن خِيارِكُم .(2)
والسبب في عدم طاعتهم للنبيّ صلى الله عليه و آله وطعنهم على تأمير أُسامة هو أنّه كان أصغر منهم سنّاً ، فأبوا ذلك ، ولم يحتملوه ، ولهذا روى ابن كثير في البداية والنهاية عن سيف بن عمر عن أبي ضمرة وأبي عمرو وغيرهما عن الحسن البصري :
إنّ أبا بكر لمّا صمّم على تجهيز جيش أُسامة قال بعض الأنصار لعمر : قل له فليؤّر علينا غير أُسامة . فذكر له عمر ذلك ، فيقال : إنّه أخذ بلحيته وقال : ثكلتك أُمّك يابن الخطّاب ، أُؤمّر غير أمير رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؟!(3)
كما روى الشيخ الكليني قدس سره في الكافي :
ص: 317
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قالَ : بَيْنا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ذاتَ يَوْمٍ جالِساً إِذْ أَقْبَلَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عليه السلام ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ فِيكَ شَبَهاً مِن عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، وَ لَولا أَنْ تَقُولَ فِيكَ طَوائِفُ مِن أُمَّتِي ما قالَتِ النَّصارَى فِي عِيسَى ابنِ مَريَمَ لَقُلتُ فِيكَ قَولاً لا تَمُرُّ بِمَلإٍ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ أَخَذُوا التُّرابَ مِن تَحتِ قَدَمَيكَ يَلتَمِسُونَ بِذلِكَ البَرَكَةَ .
قالَ : فَغَضِبَ الأَعرابِيَّانِ و المُغِيرَةُ بنُ شُعبَةَ وَ عِدَّةٌ مِن قُرَيشٍ مَعَهُم فَقالُوا : ما رَضِيَ أَنْ يَضرِبَ لابنِ عَمِّهِ مَثَلاً إِلاَّ عِيسَى ابنَ مَريَمَ!
فَأَنزَلَ اللّهُ عَلى نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله فَقالَ : «وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ * وَ قَالُواْ ءَأَ لِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاَم بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ * إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِى إِسْرَ ءِيلَ * وَ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم» يَعْنِي مِنْ بَنِي هاشِمٍ «مَّلَاِئِكَةً فِى الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ»(1) .
قالَ : فَغَضِبَ الحارِثُ بنُ عَمرٍو الفِهْرِيُّ فَقالَ : اللّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الحَقَّ مِن عِندِكَ أَنَّ بَنِي هاشِمٍ يَتَوارَثُونَ هِرَقْلاً بَعدَ هِرَقْلٍ فَأَمطِرْ عَلَينا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ(2) ، فَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيهِ مَقَالَةَ الحَارِثِ وَنَزَلَت هذِهِ الآيَةُ : «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»(3) ، ثُمَّ قالَ لَهُ : يابنَ عَمرٍو إِمَّا تُبتَ وَإِمَّا رَحَلْتَ . فَقالَ : يا مُحَمَّدُ ، بَل تَجعَلُ لِسائِرِ قُرَيشٍ شَيئاً مِمَّا فِي يَدَيكَ فَقَد ذَهَبَت بَنُو هاشِمٍ بِمَكرُمَةِ العَرَبِ والعَجَمِ . فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : لَيسَ ذلِكَ إِلَيَّ ذلِكَ إِلَى اللّهِ تَبارَكَ وتَعالَى . فَقالَ : يا مُحَمَّدُ ، قَلْبِي ما يُتابِعُنِي عَلَى التَّوبَةِ ولَكِنْ أَرْحَلُ عَنكَ .
فَدَعا بِراحِلَتِهِ فَرَكِبَها فَلَمَّا صارَ بِظَهرِ المَدِينَةِ أَتَتْهُ جَنْدَلَةٌ فَرَضَخَت هامَتَهُ ثُمَّ أَتَى الوَحيُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَقالَ : «سَأَلَ سَآئِلُم بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِّلْكَفِرِينَ» بِوَلايَةِ عَلِيٍّ
ص: 318
«لَيْسَ لَهُو دَافِعٌ * مِّنَ اللَّهِ ذِى الْمَعَارِجِ»(1) ... .(2)
وهذا يبيّن ما كانت تنطوي عليه نفوسهم المريضة من عدم إذعانهم لما يقوله رسول اللّه صلى الله عليه و آله الذي قال الباري في حقّه :
«وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى» .(3)
كما ينقل لنا أرباب التأريخ والحديث أيضاً في قضيّة تأمير أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّ بعض المسلمين قال للنبي صلى الله عليه و آله : «هذا شيء منك أم من اللّه ؟!» ، فروى القرطبي في تفسير الآيات : «سَأَلَ سَآئِلُم بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُو دَافِعٌ»(4) :
وقيل : إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفهري ، وذلك أنّه لمّا بلغه قول النبيّ صلى الله عليه و آله في عليّ رضى الله عنه : مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيُّ مَولاهُ ركب ناقته فجاء حتّى أناخ راحلته بالأبطح ثمّ قال : يا محمّد ، أمرتنا عن اللّه أن نشهد أن لا إله إلا اللّه وأنّك رسول اللّه ، فقبلناه منك ، وأن نصلّي خمساً ، فقبلناه منك ، ونزكّي أموالنا ، فقبلناه منك ، وأن نصوم شهر رمضان في كلّ عام ، فقبلناه منك ، وأن نحجّ ، فقبلناه منك ، ثمّ لم ترضَ بهذا حتّى فضّلت ابن عمّك علينا ! أ فهذا شيء منك أم من اللّه ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : وَاللّه ِ الَّذي لا إلهَ إلاّ هُوَ ما هُوَ إلاّ مِنَ اللّه ِ ، فولّى الحارث وهو يقول : اللّهمّ إن كان ما يقول محمّد حقّاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم(5) . فوَاللّه ما وصل إلى ناقته حتّى رماه اللّه بحجرٍ فوقع على دماغه ، فخرج من دبره فقتله ، فنزلت : «سَأَلَ سَآِئِلُم بِعَذَابٍ وَاقِعٍ» الآية .(6)
ونقل الشيخ الأميني أعلى اللّه مقامه في كتابه القيّم «الغدير» تفسير الآية من سورة
ص: 319
المعارج نقلاً عن جملة من كتب أهل السنّة ، فروى عن شمس الدين الشربيني القاهري الشافعي - المتوفّى ( 977 ) - في تفسيره السراج المنير :
اختلف في هذا الداعي ، فقال ابن عبّاس : هو النضر بن الحرث ، وقيل : هو الحرث بن النعمان ، وذلك أنّه لمّا بلغه قول النبيّ صلى الله عليه و آله : مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ ركب ناقته فجاء حتّى أناخ راحلته في الأبطح ، ثمّ قال : يا محمّد ، أمرتنا عن اللّه أن نشهد أن لا إله إلا اللّه وأنّك رسول اللّه ، فقبلناه منك ، وأن نصلّي خمساً ونزكّي أموالنا ، فقبلنا منك ، وأن نصوم شهر رمضان في كلّ عام ، فقبلناه منك ، وأن نحجّ ، فقبلناه منك ، ثمّ لم ترضَ حتّى فضّلتَ ابن عمّك علينا ! أفهذا شيء منك أم من اللّه تعالى ؟
فقال النبي صلى الله عليه و آله : وَالَّذي لا إلهَ إلاّ هُوَ ما هُوَ إلاّ مِنَ اللّه ِ ، فولّى الحرث وهو يقول : اللّهمّ إن كان ما يقول محمّد حقّاً فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو ائتنا بعذاب أليم . فواللّه ما وصل إلى ناقته حتّى رماه اللّه تعالى بحجر فوقع على دماغه ، فخرج من دبره فقتله ، فنزلت : «سَأَلَ سَآئِلُم بِعَذَابٍ وَاقِعٍ» الآيات .(1)
كما نقل عن شمس الدين الحفني الشافعي - المتوفّى (1181 ه- ) - ما قاله أثناء شرح قول النبيّ صلى الله عليه و آله يوم الغدير : «مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ» :
لمّا سمع ذلك بعض الصحابة قال : أما يكفي رسول اللّه أن نأتي بالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ... إلخ ، حتّى يرفع علينا ابن أبي طالب ؟! فهل هذا من عندك أم من عند اللّه ؟ فقال صلى الله عليه و آله : وَاللّه ِ الَّذي لا إلهَ إلاّ هُوَ إنَّهُ مِن عِندِ اللّه ِ . فهو دليل على عظم فضل علي عليه السلام .(2)
ونقل هذا المضمون عن جملة من أعلام أهل السنّة ، فمن أراد التفصيل فليراجع كتاب الغدير .
ومن ذلك أيضاً ما رواه الشيخ الكليني قدس سره :
ص: 320
الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن مُعَلَّى بنِ مُحَمَّدٍ عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدٍ الهاشِمِيِّ قالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَن أَحمَدَ بنِ عِيسَى قالَ : حَدَّثَنِي جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عليهم السلام فِي قَولِهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا»(1) قالَ : لَمَّا نَزَلَت : إِنَّما «وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ كِعُونَ»(2) اجتَمَعَ نَفَرٌ مِن أَصحابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي مَسجِدِ المَدينَةِ فَقالَ بَعضُهُم لِبَعضٍ : ما تَقُولُونَ فِي هذِهِ الآيَةِ ؟ فَقالَ بَعضُهُم : إِن كَفَرنا بِهذِهِ الآيَةِ نَكفُرُ بِسائِرِها ، وَ إِن آمَنَّا فَإِنَّ هَذا ذُلٌّ حِينَ يُسَلِّطُ عَلَينا ابنَ أَبي طالِبٍ . فَقالُوا : قَد عَلِمنا أَنَّ مُحَمَّداً صادِقٌ فِيما يَقُولُ وَ لكِنَّا نَتَوَلاّهُ وَ لا نُطِيعُ .(3)
فهذه النماذج وغيرها تبيّن وجود بقايا من أخلاق الجاهليّة وعصبيّتها في نفوس المسلمين بعد مضي تمام تلك السنين إلى جانب النبيّ صلى الله عليه و آله ، فإنّ نصب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير كان في أواخر حياته صلى الله عليه و آله ، ومع ذلك نجد عدم تحمّل بعض المسلمين لذلك ، وهذا ما يكشف عن عمق جذور تلك الأخلاق في نفوسهم .
ومن هنا نعرف السرّ في خوف النبيّ صلى الله عليه و آله من تبليغ ما أُمر به في عليّ عليه السلام ، والسرّ في خطاب اللّه تعالى نبيّه الكريم بهذا اللحن الشديد ، بقوله : «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» .(4)
وبهذا تبرز وتتبيّن الحاجة إلى استعمال أساليب رصينة لمواجهة هذه الرذائل والأخلاق الدنيئة بحيث تتناسب مع خطورتها وآثارها السيّئة من جانب ، ومع رسوخها في نفوسهم طيلة قرون من جانب آخر .
فكان المسلمون ينكرون التفسير الوارد في عليّ عليه السلام ولا يصدّقون به ؛ لتصوّرهم
ص: 321
أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله يريد رفع شأن عليّ باعتباره ابن عمّه ، ولهذا كانوا يعترضون عليه في المواقف المختلفة بقولهم : «هل هذا من عندك أم من عند اللّه ؟» ، فكان من الأساليب التي استخدمها النبيّ صلى الله عليه و آله في مواجهة ذلك هو أن يبيّن للمسلمين ما يتعلّق بعلي عليه السلام من خلال نقله عن جبرئيل عليه السلام ، فكان جبرئيل ينزل بالآية وتفسيرها على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وهذا ما صرّحت به بعض الروايات نظير الرواية التالية :
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ إِسْحاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِما عليهما السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُو إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّ سِخُونَ فِى الْعِلْمِ» فَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله أَفْضَلُ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِيعَ ما أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ التَّنْزِيلِ وَ التَّأوِيلِ ، وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يُعَلِّمْهُ تَأْوِيلَهُ ، وَ أَوْصِياؤهُ مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُونَهُ كُلَّهُ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ إِذا قالَ العالِمُ فِيهِمْ بِعِلْمٍ فَأَجابَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ : «يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِى كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا» وَ الْقُرْآنُ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ وَ ناسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ ، فَالرَّاسِخُونُ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَهُ .(1)
فقوله عليه السلام : «جَمِيعَ ما أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ التَّنْزِيلِ وَ التَّأوِيلِ» صريح في أنّ التأويل ينزل على النبي صلى الله عليه و آله من السماء ويأتيه من قبل اللّه عزّوجلّ ، وقد علّمه النبيّ صلى الله عليه و آله عليّاً عليه السلام ، وعلّمه عليّ عليه السلام للأوصياء من بعده كما صرّحت به الرواية التالية :
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قالَ : وَ اللَّهِ لَقَدْ قالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام : إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ ، فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام ، قالَ : وَ عَلَّمَنا وَ اللَّهِ .(2)
فلمّا كان النبيّ صلى الله عليه و آله أو أحدٌ من أهل بيته عليهم السلام يبيّن ويفسّر للناس الآيات الواردة في عليّ عليه السلام كانوا يقولون : «هكذا واللّه نزلت» ، أو «هكذا و اللّه نزلت على محمَّد صلى الله عليه و آله » ، أو «هكذا و اللّه نزل بها جبرئيل عليه السلام على محمَّد صلى الله عليه و آله » ، والمراد هو : «بهذا المعنى نزلت» أو
ص: 322
فقل : «هكذا نزلت مع تفسيرها أو تأويلها» .
ولا ريب أنّ هذا الاُسلوب له أثره البالغ في المخاطبين من الناحية النفسيّة ، ممّا يساعد على قبولهم المعاني المذكورة لهم ، وهذا ما نجده بالوجدان ؛ فإذا ورد علينا الخبر وفيه «أخبرني أبي عن جدي رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عن اللّه بكذا» فإنّه يختلف عن الخبر الوارد عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله مباشرة ومن دون نقله عن جبرئيل عليه السلام . ومن جانب آخر فإنّ لهذا الاُسلوب أثرا بالغا في ترسيخ المعاني المذكورة أيضاً ؛ فإنّه يكشف عن مدى أهمّية هذا الموضوع بحيث يتصدّى الباري عزّوجلّ لبيانه .
فالتأثير الإيجابي للاُسلوب المستخدم وما له من جذور في علم النفس ، مأخوذ بنظر الاعتبار في الأساليب التي ينهجها النبيّ صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام في عرض المعلومات والحقائق للناس ، وليس أمراً جزافيّاً ، ولعل هذا داخل في قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله :
إِنَّا مَعاشِرَ الأنبياءِ أُمِرنا أَن نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِم .(1)
الذي يدلّ على مراعاة جميع الأنبياء عليهم السلام لحالات الناس المختلفة ، ومقدار تحمّلهم للحقائق المعروضة عليهم حين تبليغ الرسالات .
لم تكن الأدوات المستخدمة في عملية الكتابة آنذاك كما هي عليه هذا اليوم ، فلم تكن الأوراق كالأوراق الموجودة هذا اليوم ، وإنّما كانت الكتابة على الجلد والخشب ونظائرهما ، والحصول عليهما صعب بالقياس إلى الحصول على الورق في عصرنا الحاضر كما لا يخفى . من جانب آخر فإنّ أسعار الجلود مرتفعة غالباً ، ممّا يفرض على الكاتب اختصار الكتابة .
كما أنّ الأقلام لم تكن نظير الأقلام المتنوّعة في العصر الحاضر ، ولا الكتابة بها كالكتابة بهذه ، بل كانت الكتابة بالقصب والريش ونظائرها ، ولا ريب أنّ الكتابة بها
ص: 323
تستغرق وقتاً أكثر ، مع ما يواجهه الكاتب من صعوبات ؛ نظير لزوم إدخال القلم في الدواة بعد كتابة كلّ كلمة أو كلمتين ، بخلاف الكتابة بالأقلام المتعارفة في هذا العصر .
فمن خلال إلقاء نظرة إلى الكتابة ، ووسائلها القرطاسيّة في ذلك العصر ، وما كانت تواجهه من مشاكل ، يُعرف بوضوح أنّ الاُسلوب المناسب لكتابة التفسير هو التفسير المختصر ، وأفضل التفاسير المختصرة بياناً ووقعاً في النفوس هو التفسير المزجي .
علماً أنّ التفسير المزجي يعلق ويرسخ في ذهن السامع والقارئ بسرعة ، بخلاف غيره من التفاسير ؛ وذلك أنّ العبارة الحاصلة بعد التفسير تكون منسجمة ولا يشعر القارئ بتفكّك بين أجزائها ، فتعلق وترسخ بسهولة في ذهنه . ولعلّ أحد أسباب توهّم إرادة التحريف من هذه الروايات هو تفسير الآيات تفسيراً مزجيّاً .
والذي يعزّز هذا الوهم ويقوّيه هو عدم فصل الآيات عن غيرها بأقواس ونحوها ، أو فقل : لم تكن في الكتابة آنذاك علائم ترقيم تميّز الآية عن غيرها كما هو اليوم في الكتب المطبوعة والمحقّقة ، بل الكتابة سابقاً نظير كتابة الكتب الحجرية والمخطوطات القديمة ، بخلاف الكتب المطبوعة والمحقّقة التي تفرز عباراتها الواحدة عن الأُخرى بفارزة أو نقطة ، وتميّز آياتها بأقواس خاصة وخطّ معيّن كما صنعناه نحن عند إيراد الروايات ، فهذا له الأثر البالغ في رفع هذا التوهّم كما هو واضح .
إذا كان المراد من الروايات المذكورة هو إثبات حذف شيء من القرآن لكان من المناسب التعبير ب- «حذفوا منه ذلك» أو «فحذفوها» أو نظير ذلك ، ولو في بعض الروايات ، مع أنّنا لا نجد ذلك في شيء من الروايات .
بل إنّ المناسب للروايات التي ورد فيها : «نَزَلَ القُرْآنُ أثْلاثاً : ثُلُثٌ فِينَا وَفِي عَدُوِّنَا ، وَثُلُثٌ سُنَنٌ وَأمْثَالٌ ، وَثُلُثٌ فَرَائِضُ وَأحْكَامٌ» أو «نَزَلَ القُرْآنُ أرْبَعَةَ أرْبَاعٍ ؛ رُبُعٌ فِينَا ،
ص: 324
وَرُبُعٌ فِي عَدُوِّنَا ، وَرُبُعٌ سُنَنٌ وَأمْثَالٌ ، ورُبُعٌ فَرَائِضُ وَأحْكَامٌ» أن تبيّن أنّ الربع الذي هو في أهل البيت عليهم السلام قد حذف من القرآن . لكن لا نجد ذلك في شيء من الروايات الواردة في الكافي أو غيره من المصادر الحديثيّة .
ومن جانب آخر فإنّنا لا نجد آية واحدة في المصحف الشريف فيها تصريح بأسماء أهل البيت عليهم السلام ، فإن كانت يد التحريف قد نالت القرآن الكريم لوصل إلينا بعض هذه الآيات التي صرّح فيها بأسماء أهل البيت عليهم السلام ، بل لوصلت إلينا - على الأقلّ - آية واحدة منها .
وممّا يؤيّد ذلك أيضاً ما ذكره السيد الخوئي قدس سره بقوله :
وممّا يدلّ على أنّ اسم أمير المؤنين عليه السلام لم يذكر صريحاً في القرآن حديث الغدير ؛ فإنّه صريح في أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله إنّما نصب عليّاً بأمر اللّه ، وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك ، وبعد أن وعده اللّه بالعصمة من الناس ، ولو كان اسم عليّ مذكوراً في القرآن لم يحتج إلى ذلك النصب ، ولا إلى تهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين ، ولما خشي رسول اللّه صلى الله عليه و آله من إظهار ذلك ، ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ .(1)
تقدّم أنّ الروايات يجب أن تفهم بما يحيطها من القرائن ، وأنّ للقرائن دوراً أساسياً في فهمها الصحيح ، ولا ريب في أنّ فهم الروايات بمعزل عن القرائن هو فهم خاطئ .
كما تقدّم أيضاً أنّه كلّما ازداد الفاصل الزمني بين صدور النصّ وبين السامع أو القارئ فإنّ القرائن المحيطة والحافّة بالنصّ ستغيب وتضيع شيئاً فشيئاً . ومن جملة القرائن لفهم الأخبار هي فهم أصحاب الأئمّة عليهم السلام والعلماء الذين يقاربون زمان صدور النصّ ، وهو المعبّر عنه بالتلقّي ، فإنّ فهم هؤلاء الأجلاّء قرينة مهمّة لفهم
ص: 325
الأخبار ؛ باعتبارهم قريبين من تلك القرائن المحيطة والمكتنفة للخبر أو الأخبار ، بل هم يعيشون نفس الأجواء ، وتحكمهم نفس المرتكزات التي كانت في ذلك الزمان وفي ذلك المجتمع .
وفي المقام نجد أنّ الشيخ الكليني قدس سره أورد هذه الروايات في بابٍ عنوانُه : «بابٌ فيه نُكتٌ و نُتَفٌ من التَّنزيل في الوَلاية» ، ولم يورد شيئاً منها في «كتاب فضل القرآن» بأبوابه المتنوّعة والمتعدّدة ، وهذا يعني أنّه لم يفهم منها التحريف أصلاً - وإلاّ لأوردها أو بعضها في أبواب القرآن - ، وإنّما فهم منها التفسير ، وأنّ هذه الآيات مفسّرة في الولاية ، لا أنّ لفظ الآية هو ما ورد في الرواية ، مع دقّة الشيخ الكليني قدس سره الفائقة ، وعظمته في الحديث بحيث قال الشيخ النجاشي في وصفه :
شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ، ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث ، وأثبتهم . . . ومات أبو جعفر الكليني رحمه الله ببغداد سنة تسع وعشرين وثلاثمئة ، سنة تناثر النجوم(1) .
كما وصفه السيّد علي بن طاووس قدس سره بقوله :
كان حياته في زمن وكلاء المهدي عليه السلام عثمان بن سعيد العمري ، وولده أبي جعفر محمّد ، وأبي القاسم حسين بن روح ، وعلي بن محمّد السمري ، وتوفي محمّد بن يعقوب قبل وفاة علي بن محمّد السمري .. . فتصانيف هذا الشيخ محمّد بن يعقوب ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين(2) .
ففهم هذا الشيخ الجليل والمحدّث الخبير لهذه الروايات قرينة مهمّة للفهم الصحيح للأخبار ، وقد أدرجها جميعاً في «باب فيه نُكتٌ و نُتَفٌ من التَّنزيل في الوَلاية» ، وهذا يعني أنّه فهم منها التفسير ، ولم يفهم منها التحريف ، وهذا الفهم قرينة
هامّة باعتبار قربه من عصر النص ، خصوصاً وأنّه معاصر للنوّاب الأربعة للإمام الحجّة عجّل اللّه فرجه الشريف .
ص: 326
من الأُمور التي يجب أخذها بنظر الاعتبار في فهم الروايات هو أنّ الفهم الصحيح للأخبار هو الفهم الذي يكون نابعاً من مجموع الروايات الواردة في الباب ، لا أن يكون النظر منحصراً فيها وبمعزل عن غيرها من الروايات ، وذلك أنّ بعض الروايات يبيّن ويفسّر البعض الآخر ، وهذا ما يسمّى ب-«الاُسرة الحديثية» .
وإذا لاحظنا الروايات الأُخرى وجدناها تؤيّد ما فهمه الكليني قدس سره ؛ من عدم دلالة الروايات المذكورة على التحريف ، فبعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلامتفيد نفس المضمون الوارد في هذه الروايات من دون إيهامها للتحريف ، نظير الرواية التالية التي رواها الشيخ الكليني قدس سره عن الإمام الباقر عليه السلام ، وإليك نصّها :
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحابِنا عَنْ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صالِحٍ عَن جابِرٍ عَن أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ لَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُو عَزْمًا»(1) قالَ عَهِدْنا إِلَيْهِ فِي مُحَمَّدٍ وَ الأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ فَتَرَكَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْمٌ أَنَّهُمْ هَكَذا وَ إِنَّما سُمِّيَ أُولُو العَزْمِ أُوْلِي العَزْمِ لأَنَّهُ عَهِدَ إِلَيْهِمْ فِي مُحَمَّدٍ والأَوْصِياءِ مِنْ بَعْدِهِ وَ المَهْدِيِّ وَ سِيرَتِهِ وَ أَجْمَعَ عَزْمُهُمْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَ الإِقْرارِ بِهِ .(2)
حيث إنّها صريحة في أنّ المراد من المعنى المذكور فيها هو التفسير لا التحريف ، وهذا المعنى شبيه بالمعنى المذكور في الرواية التالية التي رواها الشيخ الكليني وادّعي دلالتها على التحريف :
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى القُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ «وَ لَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ» كَلِمَاتٍ فِي مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ
ص: 327
الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الأَئِمَّةِ عليهم السلام مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ «فَنَسِىَ» هَكَذا وَ اللَّهِ نَزَلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله .(1)
كما أنّ الرواية التالية والتي رواها العلاّمة المجلسي قدس سره نقلاً عن المناقب وهي :
يَزيدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ عَن زَينِ العابِدينَ عليه السلام أنَّهُ قالَ في قَولِ اللّهِ : «بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ
بِهِى أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا» قالَ : بِالوَلايَةِ عَلى(2) أميرِ المُؤمِنينَ وَالأَوصِياءِ مِن وُلدِهِ .(3)
لا توهم التحريف ، وهي شبيهة بالرواية التالية التي رواها الشيخ الكليني :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ مُنَخَّلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قالَ : نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام بِهَذِهِ الآيَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله هَكَذا : «بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِى أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ» فِي عَلِيٍّ «بَغْيًا» .(4)
مع أنّ رواية الكافي توهم التحريف ، بخلاف رواية المناقب ، وبه يتّضح أنّ المراد من رواية الكافي هو بيان معنى الآية ، لا إثبات التحريف .
كما أنّ الخبر التالي المروي في البحار نقلاً عن تفسير العيّاشي :
عَن أبي بَصيرٍ عَن أبي عَبدِ اللّه ِ عليه السلام : .. . و لَو أَنَّ أهلَ الخِلافِ «فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِى لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ»(5) يَعني في عَلِيٍّ عليه السلام .(6)
يؤيّد أنّ المراد بالروايتين المرويّتين في الكافي هو التفسير ، وهما :
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام «وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ» فِي
ص: 328
عَلِيٍّ «لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ» .(1)
أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قالَ : هَكَذا نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ : «وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ» فِي عَلِيٍّ «لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ» .(2)
ومن خلال الرواية التالية المرويّة في البحار نقلاً عن بصائر الدرجات :
مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ ، عَنِ النَّضَرِ ، عَن عَبدِ الغَفّارِ ، عَن أبي عَبدِ اللّه ِ عليه السلام ، قالَ : إنَّ اللّه َ تَعالى قالَ لِنَبِيِّهِ : «شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِى نُوحًا وَ الَّذِى أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِى إِبْرَ هِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى» مِن قَبلِكَ «أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ» إنَّما يَعنِي الوَلايَةَ «كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ»(3) يَعني كَبُرَ عَلى قَومِكَ يا مُحَمَّدُ ما تَدعوهُم إلَيهِ مِن تَولِيَةِ عَلِيِ عليه السلام ، قالَ : إنَّ اللّهَ قَد أخَذَ ميثاقَ كُلِّ نَبِيٍّ وكُلِّ مُؤمِنٍ لَيُؤمِنَنَّ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله و عَلِيٍّ وبِكُلِّ نَبِيٍّ وبِالوَلايَةِ ، ثُمَّ قالَ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله : «أُوْلَائِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَئاهُمُ اقْتَدِهْ»(4) يَعني آدَمَ ونوحاً وكُلٌّ نَبِيٍّ بَعدَهُ .(5)
يتّضح المقصود من الرواية التي رواها محمَّد بن سنان عن الرِّضا عليه السلام ، وهي :
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضا عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ» بِوَلايَةِ عَلِيٍّ «مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ» يَا مُحَمَّدُ مِنْ وَلايَةِ عَلِيٍّ ، هَكَذَا فِي الْكِتَابِ مَخْطُوطَةٌ .(6)
ويتّضح المقصود من الرواية المرويّة في الكافي (ج 1 ص 420 ح 43) من خلال الاطّلاع على ما رواه في تأويل الآيات الظاهرة بقوله :
ص: 329
حَدَّثَني أبي عَن إسماعيلَ بنِ مرارٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ الفُضَيلِ عَن أبي عَبدِ اللّه ِ عليه السلام ، قالَ : سَأَلتُهُ عَن قَولِ اللّه ِ عَزَّوجَلَّ : «ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ»(1) ، وقولِهِ تَعالى : «ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ»(2) ، قالَ : إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لَمّا أخَذَ الميثاقَ لِأَميرِ
المُؤمِنينَ قالَ : أ تَدرونَ مَن وَلِيُّكُم مِن بَعدي ؟ قالوا : اللّه ُ و رَسولُهُ أعلَمُ . فَقالَ : إنَّ اللّه َ يَقولُ : «وَ إِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ»(3) يَعني عَلِيّا هُوَ وَلِيُّكُم مِن بَعدي . هذِهِ الاُولى .
وأمّا المَرَّةُ الثّانِيَةُ : لَمّا أشهَدَهُم يَومَ غَديرِ خُمِّ وقَد كانوا يَقولونَ : لَئِن قَبَضَ اللّه ُ مُحَمَّداً لا نُرجِعُ هذَا الأَمرَ في آلِ مُحَمَّدٍ ولا نُعطيهِم مِنَ الخُمسِ شَيئاً فَأَطلَعَ اللّه ُ نَبِيَّهُ عَلى ذلِكَ وأنزَلَ عَلَيهِ : «أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَیٰهُم بَلَى وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ»(4) ، وقال أيضاً فيهِم : «
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ * أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ * إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّواْ عَلَى أَدْبَارِهِم مِّنم بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلَى لَهُمْ» وَالهُدى سَبيلُ المُؤمِنينَ «الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلَى لَهُمْ»(5) .(6)
كما أنّ ملاحظة الروايات الواردة في شأن نزول الآيات من سورة المعارج يؤيّد أنّ المراد من الرواية المرويّة في الكافي (ج 1 ص 422 ح 47) هو التفسير ، فمن ذلك ما رواه في البحار نقلاً عن تفسير فرات :
ص: 330
أبو أحمَدٍ يَحيَى بنُ عُبَيدِ بنِ القاسِمِ القَزوينِيُّ مُعَنعَنا عَن أبي وَقّاصٍ قالَ : صَلّى بِنَا النَّبِيُّ صَلاةَ الفَجرِ يَومَ الجُمُعَةِ ، ثُمَّ أقبَلَ عَلَينا بِوَجهِهِ الكَريمِ الحَسَنِ ، وأثنى عَلَى اللّه ِ تَعالى فَقالَ : أخرُجُ يَومَ القِيامَةِ وعَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ عليه السلام أمامي ، وبِيَدِهِ لِواءُ الحَمدِ وهُوَ يَومَئِذٍ شقَّتانِ ؛ شقَّةُ مِنَ السُّندُسِ ، وشقَّةٌ مِن الإستَبرَقِ . فَوَثَبَ إلَيهِ رَجُلٌ أعرابِيُّ مِن أهلِ نَجدٍ مِن وُلدِ جَعفَرِ بنِ كِلابِ بنِ رَبيعَةَ فَقالَ : قَد أرسَلوني إلَيكَ لِأَسأَلَكَ فَقالَ : قُل يا أخَا البادِيةِ . قالَ : ما تَقولُ في عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ فَقَد كَثُرَ الاِختِلافُ فيهِ؟ فَتَبَسَّمَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ضاحِكاً فَقالَ : يا أعرابِيُّ ولِمَ كَثّرتَ الاِختلافَ فيهِ! عَلِيٌّ مِنّي كَرَأسي مِن بَدَني ، زِرّي مِن قَميصي . فَوَثَبَ الأَعرابِيُّ مُغضَباً ثُمَّ قالَ : يا مُحَمَّدُ ، إنّي أشَدُّ مِن عَلِيِّ بَطشاً فَهَل يَستَطيعُ عَلِيٌّ أن يَحمِلَ لِواءَ الحَمدِ ؟ فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : مَهلاً يا أعرابِيُّ فَقَدَ أعطاهُ اللّه ُ يَومَ القِيامَةِ خِصالاً شَتّى : حُسنَ يوسُفَ ، وزُهدَ يَحيى ، وصَبرَ أيّوبَ ، وطولَ آدَمَ ، وقُوَّةَ جَبرَئيلَ عَلَيهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، وبِيَدِهِ لِواءُ الحَمدِ ، وكُلُّ الخَلائِقِ تَحتَ الِلّواءِ ، وتَحُفُّ بِهِ الأَئِمَّةُ وَالمُؤَذِّنونَ بِتِلاوَةِ القُرآنِ وَالأَذانِ ، وهُمُ الَّذينَ لا يَتَدَوَّدونَ في قُبورِهِم . فَوَثَبَ الأَعرابِيُّ مُغضَباً وقالَ : اللّهُمَّ إن يَكُن ما قالَ مُحَمَّدٌ حَقّاً فَأَنزِل عَلَيَّ حَجَراً . فَأَنزَلَ اللّهُ فيهِ : «سَأَلَ سَآئلُم بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُو دَافِعٌ * مِّنَ اللَّهِ ذِى الْمَعَارِجِ »(1) .(2)
وما أورده في العمدة نقلاً عن تفسير الثعلبي :
بِالإِسنادِ المُقَدَّمِ قالَ : وسَأَلَ سُفيانُ بنُ عُيَينَةَ عَن قَولِ اللّهِ عَزَّوجَلَّ : «سَأَلَ سَآئِلُم بِعَذَابٍ وَاقِعٍ» في مَن نَزَلَت ؟ فَقالَ : لَقَد سَأَلتَني عَن مَسأَلَةٍ ما سَأَلَني عَنها أحَدٌ قَبلَكَ ، حَدَّثَني جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن آبائِهِ عليهم السلام قالَ : لَمّا كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِغَديرِ خُمٍّ نادَى النّاسَ فَاجتَمَعوا فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ عليه السلام فَقالَ : مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ . فَشاعَ ذلِكَ وطارَ فِي البِلادِ ، فَبَلَغَ ذلِكَ الحارِثَ بنَ نُعمانَ الفِهِريَّ فَأَتى رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلى ناقَةٍ لَهُ حَتّى أتَى الأَبطَحَ فَنَزَلَ عَن ناقَتِهِ فَأَناخَها وعَقَلَها ، ثُمَّ أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله وهُوَ
ص: 331
في مَلاَءِ مِن أصحابِهِ فَقالَ : يا مُحَمَّدُ ، أمَرتَنا عَنِ اللّهِ أن نَشهَدَ أن لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وأَنَّكَ رَسولُ اللّهِ فَقَبِلناهُ مِنكَ ، وأمَرتَنا أن نُصَلِّيَ خَمسا فَقَبِلناهُ مِنكَ ، وأمَرتَنا أن نَصومَ شَهرا فَقَبِلناهُ مِنكَ ، وأمَرتَنا أن نَحِجَّ البَيتَ فَقَبِلناهُ ، ثُمَّ لَم تَرضَ بِهذا حَتّى رَفَعتَ بِضِبعَي ابنِ عَمِّكَ فَفَضَّلتَهُ عَلَينا فَقُلتَ : مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ ، وهذا شَيءُ مِنكَ أم مِنَ اللّهِ تَعالى ؟ فَقالَ : وَالَّذي لا إلهَ إلاّ هُوَ إنَّهُ مِن أمرِ اللّه . فَوَلَّى الحارِثُ بنُ نُعمانَ يُريدُ راحِلَتَهُ وهُوَ يَقولُ : اللّهُمَّ إن كانَ ما يَقولُهُ مُحَمَّدٌ حَقّا فَأَمطِر عَلَينا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ ، أوِ ائتِنا بِعَذابٍ أليمٍ ، فَما وَصَلَ إلَيها حَتّى رَماهُ اللّه ُ بِحَجَرٍ فَسَقَطَ عَلى هامَتِهِ وخَرَجَ مِن دُبُرِهِ فَقَتَلَهُ ، وأنزَلَ اللّه ُ تَعالى : «سَأَلَ سَآئِلُم بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُو دَافِعٌ» .(1)
كما أنّ الذي يتصفّح الروايات الكثيرة الواردة في شأن نزول الآية : «هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فِى رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ» الدالّة على نزولها في عليّ عليه السلام وحمزة وعبيدة وأعدائهم يوم بدر ، يتّضح له بجلاء أنّ المقصود من الرواية المروية في الكافي (ج 1 ص 422 ح 51) هو بيان وجه من الوجوه ومعنىً من معاني الآية الكريمة ، وهو المعنى المختصّ بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ، وإليك نموذجاً من هذه الروايات ؛ فروى المجلسيّ قدس سره في البحار نقلاً عن تفسير فرات :
عبد السلام بن ملك وسعيد بن الحسن بن ملك معنعنا عن السدي قال : «هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فِى رَبِّهِمْ» الآيتين نزلت في عليّ وحمزة وعبيدة بن الحارث ، وفي عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة ، بارزهم يوم بدر عليّ وحمزة و عبيدة بن الحارث ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : هؤُلاءِ الثَّلاثَةُ يَومَ القِيامَةِ كَواسِطَةِ القِلادَةِ فِي المُؤمِنينَ ، وهؤُلاءِ الثَّلاثَةُ كَواسِطَةِ القِلادَةِ فِي الكُفّارِ .(2)
وأمّا الرواية المرويّة في الكافي (ج 1 ص 424 ح 64) فممّا يؤيّد دلالتها على التفسير دون التحريف هو ما رواه في بحار الأنوار نقلاً عن كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات
ص: 332
الظاهرة :
محمّد بن العبّاس عن عليّ بن عبد اللّه بن أسد عن إبراهيم الثقفيّ عن عليِّ بن هلال عن الحسن بن وهب بن عليّ بن بحيرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّوجلّ : «فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا» قال : «نَزَلَت في وَلايَةِ عَلِيِّ عليه السلام » .(1)
وأمّا الروايات الواردة في الطائفة الرابعة فهي في اختلاف القراءات ، وأنّ قراءة أهل البيت عليهم السلامتختلف عن القراءة المعروفة عن عاصم ، وهو ممّا لا حزازة فيه ؛ فإنّ اختلاف القراءات ثابت كما سبقت الإشارة إليه ، فكما تختلف قراءة عاصم عن غيره من القرّاء في موارد كثيرة ، كذلك تختلف قراءة أهل البيت عليهم السلام عن قراءة غيرهم ، ومع ذلك فإن الإمام الصادق عليه السلام يؤيّد ما قرأه بالدليل والاعتبار ، وأنّ الكتاب لا ينطِق بل يُنطق .
لا ريب أنّ كلام النبيّ صلى الله عليه و آله وأهل البيت عليهم السلام لا يدانيه كلام في الفصاحة والبلاغة ، لكنّه مع ذلك لا يداني أُسلوب القرآن الكريم ، فالقرآن الكريم له لحن ووقع خاصّ في النفس ، ولا يشبهه شيء من كلام الآدميّين في هذه الجهة ، كما لا يخفى على من له ذوق عربيّ سليم .
فما قيل من دلالة الروايات المذكورة على التحريف غير سديد ؛ فإنّ الألفاظ الواردة بين ألفاظ الآي الكريم لا تشابهها من ناحية اللحن والوقع النفسي كما هو واضح لمن راجع هذه الروايات .
ممّا يلاحظ في سيرة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام أنّهم كانوا يضمّنون كلامهم بالآيات الكريمة ، وهذا ما نجد له شواهد كثيرة في حياة أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم ،
ص: 333
وهذا الطراز من الكلام له آثار عديدة ، منها :
1 - إبراز أهميّة القرآن والاهتمام به .
2 - ربط المسلمين بالقرآن في حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة ، بل في المحاورات العرفيّة .
3 - بيان صحّة الكلام المذكور من خلال صلته بالقرآن واستناده إليه ، وأنّه ليس عارياً عن الأساس .
فإذا أخذنا بنظر الاعتبار هذا الأمر فإنّ جملة من الروايات سيتّضح المراد منها وبه تعرف الجواب عنها . ومن نماذج ذلك ما رواه الشيخ الكليني قدس سره :
أَحْمَدُ بْنُ مِهْرانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْراهِيمَ الجَعْفَرِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلِيطٍ قَالَ: لَمَّا أَوْصَى أَبُو إِبْراهِيمَ عليه السلام أَشْهَدَ إِبْراهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الجَعْفَرِيَّ وَ... أَشْهَدَهُمْ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ وَأَنَّ البَعْثَ بَعْدَ المَوْتِ حَقٌّ... وَ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَكْشِفَ وَصِيَّتِي وَلا يَنْشُرَهَا وَ هُوَ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْتُ وَسَمَّيْتُ ، فَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَمَنْ أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ(1) وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ... .(2)
وفي نهج البلاغة :
فَاتَّعِظُوا عِبَادَ اللَّهِ بِالْعِبَرِ النَّوافِعِ ، واعْتَبِرُوا بِالآيِ السَّواطِعِ ، وازْدَجِرُوا بِالنُّذُرِ البَوالِغِ ، وانْتَفِعُوا بِالذِّكْرِ والمَواعِظِ ، فَكَأَنْ قَدْ عَلِقَتْكُمْ مَخَالِبُ المَنِيَّةِ ، وانْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلائِقُ الأُمْنِيَّةِ ، وَدَهِمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ الأُمُورِ ، والسِّيَاقَةُ إِلَى الوِرْدُ المَوْرُودُ ، فَكُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ(3) سَائِقٌ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا وَ شَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا
ص: 334
بِعَمَلِهَا .(1)
وفي نهج البلاغة أيضاً :
الأَقَاوِيلُ مَحْفُوظَةٌ ، والسَّرائِرُ مَبْلُوَّةٌ(2) ، وَكُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ(3) ، والنَّاسُ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ .(4)
ومنه ما رواه الشيخ الكليني قدس سره :
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحابِنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ عَنْ أَبِي المَغْراءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قالَ : المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَخُونُهُ ، وَيَحِقُّ عَلَى المُسْلِمِينَ الاجْتِهادُ فِي التَّواصُلِ والتَّعاوُنُ عَلَى التَّعاطُفِ ، والمُواساةُ لأَهْلِ
الحاجَةِ ، وَتَعاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَكُونُوا كَما أَمَرَكُمُ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ،(5) مُتَراحِمِينَ مُغْتَمِّينَ لِما غابَ عَنْكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ، عَلَى ما مَضَى عَلَيْهِ مَعْشَرُ الأَنْصارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله .(6)
ومنه ما في الكافي أيضاً :
أَحمَدُ بنُ إِدرِيسَ عَن مُحَمَّدِ بنِ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ عَن عَمَّارِ بنِ مَروانَ عَن مُنَخَّلٍ عَن جابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ عليه السلام قالَ : «أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ» مُحَمَّدٌ(7)«بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ» بِمُوالاةِ عَلِيٍّ فَاسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا(8) مِن آلِ مُحَمَّدٍ «كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقًا
ص: 335
ومنه ما في الكافي أيضاً :
عِدَّةٌ مِنْ أصْحابِنا عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ عَنْ أبِي المَغْراءِ عَنْ أبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام قالَ المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَخُونُهُ وَيَحِقُّ عَلَى المُسْلِمِينَ الاجْتِهادُ فِي التَّواصُلِ والتَّعاوُنُ عَلَى التَّعاطُفِ والمُواساةُ لِأهْلِ الحاجَةِ وَتَعاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَكُونُوا كَما أمَرَكُمُ اللّه ُ عَزَّوَجَلَّ رُحَماءَ بَيْنَكُمْ(3) مُتَراحِمِينَ مُغْتَمِّينَ لِما غابَ عَنْكُمْ مِنْ أمْرِهِمْ عَلَى ما مَضَى عَلَيْهِ مَعْشَرُ الأنْصارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله .(4)
ومنه ما في المصباح للكفعمي :
فَراقِبُوا اللّهَ وَاتَّقوهُ ، وَاسمَعوا لَهُ وأَطيعوهُ ، وَاحذَرُوا المَكرَ ولا تُخادِعوهُ ، وفَتِّشوا ضَمائِرَكُم ولا تُوارِبوهُ وتَقَرَّبوا إلَى اللّهِ بِتَوحيدِهِ ، وطاعَةِ مَن أمَرَكُم أن تُطيعوهُ ، وَ لاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ،(5) ولا يَجنَح بِكُمُ الغَيُّ ]ولا يَجنَح بِكُمُ العَمى[ فَتَضِلّوا عَن سَبيلِ الرَّشادِ بِاتِّباعِ أولئِكَ الَّذينَ ضَلّوا وأضَلّوا ، قالَ اللّهُ عَزَّ مِن قائِلٍ في طائِفَةٍ ذَكَرَهُم بِالذَّمِّ في كِتابِهِ : «إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ * رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا»(6) ... .(7)
وبهذا يتّضح الجواب عن جملة من الروايات التي قد يتصوّر دلالتها على التحريف .
ص: 336
وهذا الاُسلوب لا يختصّ بأهل البيت عليهم السلام ، بل هو سيرة أتباعهم أيضاً ، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على سيرة أهل البيت عليهم السلام في الاستناد للقرآن ، وهذا دليل آخر على عدم إرادة تحريف القرآن من هذه الروايات ، وإلاّ لترك القرآن في معزل ، ولما وقع هذا التأكيد على الاستشهاد به .
تقدّم أنّ أحد القرائن المهمّة في فهم الحديث فهماً صحيحاً هو فهم أصحاب الأئمّة والمعاصرين لهم ، ومن قارب عصرهم ، ممّن عاش نفس الأجواء والمرتكزات العرفية الموجودة في زمان المعصوم عليه السلام ، وتقدّم أن الشيخ الكليني قدس سره قد فهم منها التفسير ، وأنّ معناها أو شأن نزولها هو ما ذكر في هذه الروايات ؛ ولهذا أوردها في باب «نُكتٌ و نُتَفٌ من التَّنزيل في الوَلاية» .
وفهم هذه الأحاديث ونظائرها بهذا الفهم لا يختصّ بعلمائنا ، بل صرّح به بعض علماء المذاهب الأُخرى أيضاً ، بل نجد استخدام هذا الاُسلوب التفسيري وهذا النحو من البيان لمعاني آيات الكتاب العزيز في سيرة أجلاّء الصحابة ، أمثال عبد اللّه بن عبّاس وابن مسعود ، ففي جامع البيان :
حدّثنا ابن المثنى ، قال : حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدّثنا سعيد بن أدهم السدوسي ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن عبد المجيد ، قال : سمعت مسلم بن عمّار ، قال : سمعت ابن عباس يقرأ هذا الحرف : «فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَام»(1) .(2)
وفي الدرّ المنثور :
أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن ابن مسعود رضى الله عنه أنّه كان يقرأ هذا
ص: 337
الحرف : «وكفى اللّه المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب» .(1)
ورواه في ميزان الاعتدال وإكمال الكمال بسندهما عن ابن مسعود بهذا اللفظ :
عن ابن مسعود أنّه كان يقرأ : «وكفى اللّه المؤمنين القتال بعلي» .(2)
كما روى في جامع البيان عن عليّ عليه السلام :
حدّثنا أبو كريب ، قال : حدّثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي مرّ ، أنّ عليّاً رضى الله عنه قرأها : «وَ الْعَصْرِ إِنَّ الاْءِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ» .(3)
وغيرها من الروايات الكثيرة(4) الصادرة عن أجلاّء الصحابة ، فإنّ سيرتهم هذه كاشفة عن معروفية هذا الاُسلوب في تلك البرهة من الزمان ، وأنّ تفسير القرآن تفسيراً مزجيّاً كان رائجاً آنذاك ، وإلاّ فلا يعقل صدور هذه الكلمات بقصد التحريف من جميع هؤلاء مع اهتمامهم بالقرآن ، ومع اختلافهم في المذاق والرأي ، ولهذا قال المفسّر الكبير الفخر الرازي في تفسيره :
اعلم أنّهم ذكروا في تفسير العصر أقوالاً : الأوّل : أنّه الدهر ، واحتجّ هذا القائل بوجوه ؛ أحدها : ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه أقسم بالدهر ، وكان عليه السلام يقرأ «وَالعَصرِ ونَوائِبِ الدَّهِر» إلاّ أنّا نقول : هذا مفسد للصلاة ، فلا نقول إنّه قرأه قرآناً ، بل تفسيراً .(5)
وهذا هو الرأي السديد في جميع ما ذكر من الروايات .
هذه القرينة من القرائن المهمّة على عدم إرادة التحريف ، وحاصلها أنّ فهم الروايات المذكورة فهماً صحيحاً يجب أن يكون بعد مراجعة اللغة والروايات التي
ص: 338
تفسّر المقصود من الألفاظ والعناوين المحوريّة والمتكرّرة الواردة فيها ، وهي «النزول» و «التأويل» ، وإليك فيما يلي استعراض مختصر لبعض ما ورد في هذين اللفظين لغةً وحديثاً :
قال الراغب الإصفهاني :
التأويل من الأوْل ؛ أي الرجوع إلى الأصل ، ومنه : الموئل ؛ للموضع الذي يُرجَعُ إليه ، وذلك هو ردّ الشيء إلى الغاية المرادة منه ، علماً كان أو فعلاً ، ففي العلم نحو : «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُو إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّ سِخُونَ فِى الْعِلْمِ»(1) وفي الفعل كقول الشاعر :
وللنوى قبل يوم البين تأويل
وقوله تعالى : «هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُو يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُو»(2) أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه . وقوله تعالى : «ذَ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً»(3) قيل : أحسن معنى وترجمة . وقيل : أحسن ثواباً في الآخرة .(4)
وقال الخليل الفراهيدي :
التأوّل والتأويل : تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ، ولا يصحّ إلاّ ببيان غير لفظه .(5)
وقال ابن الأثير :
في حديث ابن عبّاس رضى الله عنه : «اللهم فقّهه في الدين ، وعلّمه التأويل» : هو من آلَ الشيء يؤلُ إلى كذا ؛ أي رجع وصار إليه ، والمراد بالتأويل : نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ .(6)
ص: 339
قال ابن منظور :
النُّزُول: الحلول، وقد نَزَلَهم ونَزَل عليهم ونَزَل بهم يَنْزل نُزُولاً ومَنْزَلاً و مَنْزِلاً، بالكسر شاذ . وتَنَزَّله وأَنْزَله ونَزَّله بمعنىً؛ قال سيبويه: وكان أَبو عمرو يفرُق بين نَزَّلْت وأَنْزَلْت ولم يذكر وجهَ الفَرْق . وأَنزَله غيرُه واستنزله بمعنى، ونزَّله تنزيلاً،
والتنزيل أَيضاً : الترتيبُ . والتنزُّل : النُّزول في مُهْلة .(1)
وردت هاتان اللفظتان في روايات كثيرة ، إليك بعضها :
قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له عليه السلام قاله للخوارج و قد خرج إلى معسكرهم :
فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وَإِنَّ القَتْلَ لَيَدُورُ عَلَى الآباءِ وَالأَبْنَاءِ وَالإِخْوَانِ والقَراباتِ ، فَما نَزْدادُ عَلى كُلِّ مُصِيبَةٍ وَشِدَّةٍ إِلاّ إِيماناً وَمُضِيّاً عَلَى الحَقِّ ، وَتَسْلِيماً لِلأَمْرِ وَصَبْراً عَلى مَضَضِ الجِراحِ ، وَلكِنَّا إِنَّما أَصبَحنا نُقاتِلُ إِخْوانَنا فِي الإِسلامِ عَلى ما دَخَلَ فِيهِ مِنَ الزَّيْغِ والاِعْوِجَاجِ والشُّبْهَةِ والتَّأْوِيلِ .(2)
فاستُعمل التأويل فيها بمعنى حمله على معنى آخر ، والمراد هو التحريف للإسلام ، وصرفه عن معناه الحقيقي .
وروى الصفّار في بصائر الدرجات الروايات التالية :
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ عَن مُحَمَّدِ بنِ إسماعيلَ عَن مَنصورِ بنِ يونُسَ عَنِ ابنِ أُذينَةَ عَن فُضَيلِ بنِ يَسارٍ ، قالَ : سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام عَن هذِهِ الرِّوايَةِ : ما مِنَ القُرآنِ آيَةٌ إلاّ ولَها ظَهرٌ وبَطنٌ . فَقالَ : ظَهرُهُ تَنزيلُهُ ، وبَطنُهُ تَأويلُهُ ، مِنهُ ما قَد مَضى ، ومِنهُ ما لَم يَكُن ، يَجري كَما يَجرِي الشَّمسُ وَالقَمَرُ ، كُلَّما جاءَ تَأويلُ شَيءٍ مِنهُ يَكونُ عَلَى الأَمواتِ كَما يَكونُ عَلَى الأَحياءِ ، قالَ اللّهُ : «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ و إِلاَّ اللَّهُ
ص: 340
وَالرَّ سِخُونَ فِى الْعِلْمِ»(1) نَحنُ نَعلَمُهُ(2) .
فاستُعمل التأويل أوّلاً بمعنى البطن ، ثمّ بمعنى المصداق للآية ، أو فقل : ما تنطبق عليه الآية ، وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأوّل (بطن من بطون الآية) . فيكون معنى الرواية : «كلّما جاء مصداق للآية فإنّ الإمام يعلمه» .
وكذا الرواية التالية :
حَدَثَّنا أحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ عَنِ البَرقِيِّ عَنِ المرزَبانِ بنِ عِمرانَ عَن إسحاقَ بنِ عَمّارٍ ، قالَ : سَمِعتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام يَقولُ : إنَّ لِلقُرآنِ تَأويلاً ، فَمِنهُ ما قَد جاءَ ، ومِنهُ ما لَم يَجِئ ، فَإِذا وَقَعَ التَّأويلُ في زَمانِ إمامٍ مِنَ الأَئِمَّةِ عَرَفَهُ إمامُ ذلِكَ الزَّمانِ»(3) .
وأمّا هذه الرواية :
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ عَن مُحَمَّدِ بنِ أسلَمَ عَنِ ابنِ أُذَينَةَ عَن أبانٍ عَن سُلَيمِ بنِ قَيسٍ عَن أميرِ المُؤمِنينَ عليه السلام ، قالَ : كُنتُ إذا سَأَلتُ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أجابَني ، وإن فَنِيَت مَسائِلِي ابتَدَأَني ، فَما نَزَلَت عَلَيهِ آيَةٌ في لَيلٍ ولا نَهارٍ ، ولا سَماءٍ ولا أرضٍ ، ولا دُنيا ولا آخِرَةٍ ، ولا جَنَّةٍ ولا نارٍ ، ولا سَهلٍ ولا جَبَلٍ ، ولا ضِياءٍ ولا ظُلمَةٍ ، إلاّ أقرَأَنيها ، وأملاها عَلَيَّ ، وكَتَبتُها بِيَدي ، وعَلَّمَني تَأويلَها ، وتَفسيرَها ، ومُحكَمَها ، ومُتَشابهَها ، وخاصَّها ، وعامَّها ، وكَيفَ نَزَلَت ، وأينَ نَزَلَت ، وفيمَن أُنزِلَت إلى يَومِ القِيامَةِ ، دَعَا اللّه ُ لي أن يُعطِيَنى فَهماً وحِفظاً ، فَما نَسيتُ آيَةً مِن كِتابِ اللّه ِ ، ولا عَلى مَن أُنزِلَت إلاّ أملاهُ عَلَيَّ .(4)
فهي صريحة في أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يعلّم أمير المؤمنين عليه السلام كلّ آية تنزل عليه ، ويعلّمه تأويلها و تفسيرها وجميع شؤونها ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب ما يمليه عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
ص: 341
ويؤيّدها أيضاً الرواية التالية :
حَدَّثنا أحمَدُ بنُ الحُسَينِ عَن أبيهِ عَن بُكيرِ بنِ صالِحٍ عَن عَبدِ اللّه ِ بنِ إبراهيمَ بنِ عَبدِ العَزيزِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِىِّ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ جَعفَرٍ الجَعفرِيّ ، قالَ : حَدَّثَنا يَعقوبُ بنُ جَعفَرٍ ، قالَ : كُنتُ مَعَ أبِي الحَسَنِ عليه السلام بِمَكَّةَ فَقالَ لَهُ رَجُلٌ : إنَّكَ لَتُفَسِّرُ مِن كِتابِ اللّه ِ ما لَم تسمَع بِهِ . فَقالَ أبُو الحَسَنِ عليه السلام : عَلَينا نَزَلَ قَبلَ النّاسِ ، ولَنا فُسِّرَ قَبلَ أن يُفَسَّرَ فِي النّاسِ ، فَنَحنُ نَعرِفُ حَلالَهُ وحَرامَهُ ، وناسِخَهُ ومَنسوخَهُ ، وسَفَرِيَّهِ وحَضَرِيِّهِ ، وفي أيِّ لَيلَةٍ نَزَلَت كَم مِن آيَةٍ ، وفيمَن نَزَلَت ، وفيما نَزَلَت ، فَنَحنُ حُكَماءُ اللّه ِ في أرضِهِ ، وشُهَداؤهُ عَلى خَلقِهِ ، وهُوَ قَولُ اللّه ِ تَباركَ وتَعالى : «سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ»(1) فَالشَّهادَةُ لَنا ، وَالمَسأَلَةُ لِلمَشهودِ عَلَيهِ ... .(2)
فإنّها تفصح بوضوح عن علم أمير المؤمنين عليه السلام بالجوانب المختلفة للقرآن ، وعلمه بالتفسير والتأويل ، وأنّ علمه بالتفسير سابق على جميع الناس ؛ لأنّه مأخوذ عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وقد تلقّاه رسول اللّه من الوحي : «وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى»(3) ، بل هو صريح الرواية التالية :
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ إِسْحاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِما عليهما السلام ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُو إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّ سِخُونَ فِى الْعِلْمِ» فَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله أَفْضَلُ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ ، قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِيعَ ما أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ التَّنْزِيلِ وَ التَّأوِيلِ ، وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يُعَلِّمْهُ تَأْوِيلَهُ ، وَ أَوْصِياؤهُ مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُونَهُ كُلَّهُ ، وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ إِذا قالَ العالِمُ فِيهِمْ بِعِلْمٍ فَأَجابَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ : «يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِى كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا» وَ الْقُرْآنُ خَاصٌّ وَ عَامٌّ ، وَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ ، وَ ناسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ ، فَالرَّاسِخُونُ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَهُ .(4)
ص: 342
فإنّ تعليم النبيّ صلى الله عليه و آله علم التنزيل والتأويل يعني تعليمه تفسيره الظاهري وحقائقه الباطنة ، بل صريح قوله : «جَمِيعَ ما أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ التَّنْزِيلِ وَ التَّأوِيلِ» أنّه كان ينزل عليه التأويل كما كان ينزل عليه التنزيل ، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على نزول التفسير من اللّه على قلب النبيّ صلى الله عليه و آله ، وكان النبيّ يعلّمه عليّاً عليه السلام ، ولهذا كان أمير المؤمنين عليه السلام أوّل العالمين بالتفسير ؛ لأنّه أول من يسمع ويكتب من النبيّ صلى الله عليه و آله .
بل إنّ أهل البيت عليهم السلام كانوا يعلمون ذلك كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك .
ما سبق من الكلام مبنيٌّ على تسليم الظهور الأوّلي للروايات المذكورة في ادّعاء التحريف ، من دون تدقيق في متونها ، مع أنّ التدقيق في متونها قد ينتهي بنا إلى نتيجة أُخرى من دون حاجة إلى طيّ هذا الطريق وتحمّل عناء البحث عن القرائن ، وعلى الأقلّ فإنّ الروايات التي نضعها على طاولة البحث ونسلّط عليها الأضواء ستتحدّد وتتضاءل بلا ريب ، وهذا ما يختصر لنا الطريق من جانب ، ويوصلنا إلى المقصود بنحو سليم من جانب آخر .
والذي يدقّق النظر في الروايات التي ذكرت المضمون التالي :
نَزَلَ القُرْآنُ أثْلاثاً : ثُلُثٌ فِينَا وَفِي عَدُوِّنَا ، وَثُلُثٌ سُنَنٌ وَأمْثَالٌ ، وَثُلُثٌ فَرَائِضُ وَأحْكَامٌ»(1) أو «إِنَّ القُرْآنَ نَزَلَ أرْبَعَةَ أرْبَاعٍ : رُبُعٌ حَلالٌ ، وَرُبُعٌ حَرامٌ ، وَرُبُعٌ سُنَنٌ وأحْكَامٌ ، وَرُبُعٌ خَبَرُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَنَبَأُ مَا يَكُونُ بَعْدَكُمْ وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ(2) .
فإنّه سيرى عدم دلالتها على التحريف أصلاً ، فإنّ هذه الروايات لا تريد إثبات تصريح ربع القرآن أو ثلثه بأهل البيت عليهم السلام وبأسمائهم ، وهذا واضح لمن له أدنى ذوق
ص: 343
عربي سليم ، فإنّ هذا التعبير في اللُّغة العربيّة لا يدلّ على ذلك أصلاً ، وإنّما المراد من هذه الطائفة من الروايات هو أنّ مغزى وروح ومعنى هذا المقدار من الكتاب وارد في أهل البيت عليهم السلامونازل في حقّهم .
ومما يؤيّد ما ذكرناه صحّة قولك : «أنشدتُ في فلان شعراً» ، بأن يكون المقصود والمعنيّ بالشعر هو ذلك الرجل ، مع خلوّه عن ذكر اسم ذلك الرجل بالمرّة . وإن أبيتَ عن هذا فإنّ أبناء اللّغة العربيّة لا يفهمون من قولك : «أنشدتُ في فلان ألفَ بيتٍ من الشعر» أنّك ذكرته ألف مرّة ، بلا ريب ، وهذا واضح لأبناء اللغة .
كل ما ذكرناه مبني على كون الصادر عن المعصوم عليه السلام هو المتون المذكورة بهذه الخصوصيّات ، مع أنّه يجب تحصيل الاطمئنان بهذه النقطة أوّلاً وقبل البحث في دلالتها على التحريف وعدمه ، وهو ما يحصل بمراجعة النسخ المختلفة للروايات ، وملاحظة خصوصياتها المختلفة ، سواء في نسخ الكتاب المتعدّدة ، أم في غيره من الكتب والمصادر الحديثيّة ، فإنّ البحث عن معنى الحديث فرع ثبوت متنه أوّلاً كما هو واضح .
فإذا كانت نُسخ الحديث مختلفة لفظاً ، فإنّ الذي يريد إثبات دلالة هذه الروايات على التحريف فعليه أوّلاً إثبات أنّ النسخة الصحيحة للحديث هي النسخة التي تحت اختياره ، ثمّ يبرز القرائن الدالّة على دعواه .
مع أنّ الذي يراجع نسخ الأحاديث المذكورة يجد في بعضها الاختلاف ، ويرى أنّ توهّم التحريف في بعض الأحاديث المذكورة مبنيّ على إحدى النسخ دون غيرها ، فالرواية المذكورة في الطائفة السابعة مثلاً وردت في مصادر أُخرى مع كون الآية الواردة فيها طبق المصحف الشريف ، فقد ورد نفس الخبر في المحاسن للبرقي(1)
ص: 344
وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد هكذا :
عَنهُ ، عَن بَعضِ أصحابِنا رَفَعَهُ ، قالَ : قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : ما قَسَمَ اللّه ُ لِلعِبادِ شَيئا
أفضَل مِنَ العَقلِ ، فَنَومُ العاقِلِ أفضَلُ مِن سَهَرِ الجاهِلِ ، وإفطارُ العاقِلِ أفضَلُ مِن صَومِ الجاهِلِ ، وإقامَةُ العاقِلِ أفضَلُ مِن شُخوصِ الجاهِلِ ، ولا بَعَثَ اللّه ُ رَسولاً ولا نَبِيّاً حَتّى يَستَكمِلَ العَقلَ ويَكونَ عَقلُهُ أفضَلَ مِن عُقولِ جَميعِ أُمَّتِهِ ، و ما يُضمِرُ النَّبِيُّ في نَفسِهِ أفضَلُ مِن اجتِهادِ جَميعِ المُجتَهِدينَ ، وما أدّى العاقِلُ فَرائِضَ اللّه ِ حَتّى عَقلَ مِنهُ ، ولا بَلَغَ جَميعُ العابِدينَ في فَضلِ عِبادَتِهِم ما بَلَغَ العاقِلُ . إنَّ العُقَلاءَ هُم أُولُو الأَلبابِ الَّذينَ قالَ اللّه ُ عَزَّوجَلَّ : «إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ»(1) .(2)
واحتمال التحريف مبنيّ على كون الصادر من المعصوم عليه السلام هو النسخة المطابقة لمتن الكافي المطبوع ، لا غيرها ، مع أنّ نسخة الحديث في هذا الكتاب فيها خلل ، ومنشأ هذا الخلل هو اشتباه النسّاخ أو الناقلين للنسخة في نقلهم للآية ، بسبب التشابه بين الآيتين : «إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ» و «وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ» ، فوقع الخلط بينهما فقرئت هكذا : (وَ مَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ) .
أضف إلى ذلك أنّ ما ذكرناه من نسخة الحديث في الكافي مبنيّ على صحّة النسخة المطبوعة من الكافي ، مع أنّه توجد للكافي نسخ كثيرة فلابدّ من مراجعتها والاطمئنان من صحّة النسخة المطبوعة أوّلاً ، ثمّ نسبة الاشتباه لرواية الكافي ؛ وإلاّ فقد يكون منشأ الاشتباه متأخّراً عن تأليف الكافي وفي النسخ المكتوبة فيما بعد ، لا من الشيخ الكليني قدس سره ومَن تقدّمه .
وبعبارة أُخرى : يجب الاطمئنان من سلامة نسخة الكافي التي اعتمدناها كي يمكن نسبة الاشتباه للكافي والشيخ الكليني قدس سره ، إذ مع تعدّد نسخ الكتاب واختلافها في بعض الفقرات لا يمكن نسبة الاشتباه إلى الكتاب وإلى المؤلّف ، فضلاً عن نسبته
ص: 345
إلى الرواة الذين رووا الخبر أو إلى الإمام المعصوم عليه السلام .
وبعد حصول الاطمئنان من صحّة نسخة الرواية تصل النوبة إلى فهمها وتفسيرها ، ولا يمكن معاملة كلّ ما وجدناه في كتب الحديث - مهما كانت رتبتها العلمية - معاملة الحديث المقطوع صدوره من المعصوم عليه السلام ، فإنّ الحديث - كغيره - مرّ بمراحل مختلفة على مدى القرون السالفة تعرّض خلالها لاُمور مختلفة ؛ منها التصحيف والاشتباه في النقل .
دقّة الراوي في نقل الحديث لها دور هامّ في دفع توهّم التحريف ، فمن جملة ما يعتمد عليه المتكلّم في بيان مراده هو الاعتماد على لحن الكلام ، أو على الفصل بين العبارات بسكتة قصيرة الذي هو بمنزلة النقطة أو الفارزة ، وهذه السكتة لا تنقل بالألفاظ ، وإنّما يمكن بيانها من خلال أُمور أُخرى ، وقد تعكس أثرها بشكل مباشر على معنى الحديث ، فمثلاً الحديث التالي المروي في الكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه :
قالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام : الحَمَّامُ يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لا يُكْثِرُ اللَّحْمَ .(1)
يمكن قراءته هكذا : «الحَمَّامُ يَوْمٌ وَ يَوْمٌ ، لا يُكْثِرُ اللَّحْمَ» ، ويمكن قراءته بنحو آخر أيضاً وهو : «الحَمَّامُ يَوْمٌ وَيَوْمٌ لا ، يُكْثِرُ اللَّحْمَ» ، فيكون معناه مغايراً للمفهوم من القراءة الاُولى .
وهذا الأمر لا يختصّ بالحديث الشريف بل هو جارٍ في كل كلام ، بل نجده في بعض آيات الكتاب العزيز ؛ نظير الآية التالية : «ذَ لِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ»(2)
فإنّها قرئت بالوقف على «رَيْبَ» تارةً ، وبالوقف على «فِيهِ» أُخرى ، ويختلف
ص: 346
معنى الآية على كلّ منهما كما هو واضح .
وبهذا يتّضح ما ذكرناه من دور الراوي في بيان هذه السكتة ، وهذه القرينة السياقية المؤثّرة على فهم الكلام .
ومنه يظهر الجواب عن جملة من الروايات المذكورة ؛ فإنّها من هذا القبيل ؛ حيث لو كان فيها علائم تقوم مقام ما ذكر من السكوت واللّحن - كالفوارز والنقاط والأقواس وغيرها - لما أوهمت التحريف .
وبه يظهر سبب إضافة بعض الرواة ألفاظاً أثناء الرواية نظير «قال» أو «ثمّ قال» وغيرهما ، نظير الرواية التالية التي رواها الكليني قدس سره عن أبي عبيدة الحذَّاء في نفس الباب الذي روى فيه تلك الروايات ، قال :
سَأَلتُ أَبا جَعفَرٍ عليه السلام عَنِ الاستِطَاعَةِ وَ قَولِ النَّاسِ . فَقالَ وَ تَلا هذِهِ الآيَةَ : «وَ لاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ»(1) يا أَبا عُبَيدَةَ ، النَّاسُ مُختَلِفُونَ فِي إِصابَةِ القَولِ وَ كُلُّهُم هالِكٌ . قالَ قُلتُ : قَولُهُ : «إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ» ؟ قالَ : هُم شِيعَتُنا ، وَ لِرَحمَتِهِ خَلَقَهُم وَ هُوَ قَولُهُ : «وَ لِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ» يَقُولُ : لِطاعَةِ الإِمامِ الرَّحمَةُ الَّتِي يَقُولُ : وَ رَحْمَتِي «وَسِعَتْ كُلَّ شَىْ ءٍ»(2) يَقُولُ : عِلمُ الإِمامِ وَ وَسِعَ عِلمُهُ - الَّذِي هُوَ مِن عِلمِهِ - كُلَّ شَيءٍ هُم شِيعَتُنا ، ثُمَّ قالَ : «فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ»(3) يَعنِي وَلايَةَ غَيرِ الإِمامِ وَ طاعَتَهُ ثُمَّ قالَ : «يَجِدُونَهُو مَكْتُوبًا
عِندَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ» يَعنِي النَّبِيَّ وَ الوَصِيَّ وَ القائِمَ «يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ» إِذا قامَ «وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ» وَ المُنكَرُ : مَن أَنكَرَ فَضلَ الإِمامِ وَ جَحَدَهُ «وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ» أَخذَ العِلمِ مِن أَهلِهِ «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ»
وَ الخَبائِثُ : قَولُ مَن خالَفَ «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» وَ هِيَ الذُّنُوبُ الَّتِي كانُوا فِيها قَبلَ مَعرِفَتِهِم فَضلَ الإِمامِ «وَالأَغْلَالَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ» وَ الأَغلالُ : ما كانُوا
ص: 347
يَقُولُونَ مِمَّا لَم يَكُونُوا أُمِرُوا بِهِ مِن تَركِ فَضلِ الإِمامِ فَلَمَّا عَرَفُوا فَضلَ الإِمامِ وَضَعَ عَنهُم إِصرَهُم وَ الإِصرُ الذَّنبُ وَ هِيَ الآصارُ ثُمَّ نَسَبَهُم فَقالَ : «فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ» يَعنِي بِالإِمامِ «وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُو أُوْلَئِٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(1) يَعنِي الَّذِينَ اجتَنَبُوا الجِبتَ وَ الطَّاغُوتَ أَن يَعبُدُوها ... .(2)
فإنّ فصل الكلام ب- «قال» و «قلت» و «قال فقلت» و .. . له أثر بالغ على فهم السامع ودفع توهّمه ، وهذه الكلمات تقوم مقام علائم الترقيم المستعملة في الكتابة في عصرنا الحاضر .
ولهذا نجد الرواية الواحدة المرويّة عن إمام واحد قد رويت بسندين ، متن أحدهما يوهم التحريف ، بخلاف الآخر ؛ نظير الرواية التالية :
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ» الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَلايَتِنَا .(3)
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ .. . قُلْتُ قَوْلُهُ «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ» قَالَ يُوفُونَ لِلَّهِ بِالنَّذْرِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيثَاقِ مِنْ وَلايَتِنا ... .(4)
فالرواية الاُولى توهم التحريف ، مع أنّهما رواية واحدة ، والإمام القائل لها واحد ، والرواي الأصلي لها واحد وهو «محمَّد بن الفُضيل» ، بل الراوي عن «محمَّد بن الفُضيل» واحد أيضاً وهو «الحسن بن محبوب» ، وإنّما وقع الاختلاف فيها في المراحل اللاّحقة وفي النقل عن ابن محبوب .
بل نجد سقوط عبارة من الرواية سبّب هذا التوهّم ، ففي الرواية التالية :
ص: 348
عَن جابِرٍ عَن أبي جَعفَرٍ عليه السلام قالَ : أمّا قَولُهُ : «أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُم بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ»الآيَةَ ، قالَ أبو جَعفَرٍ : ذلِكَ مَثَلُ موسى وَ الرُّسُلُ مِن بَعدِهِ و عيسى ضُرِبَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله مَثَلاً فَقالَ اللّه ُ لَهُم : فَإِن جاءَكُم مُحَمَّدٌ «بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ» بِمُوالاةِ عَلِيِّ «فَفَرِيقًا»مِن آلِ مُحَمَّدٍ «كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ»فَذلِكَ تَفسيرُها فِي الباطِنِ .(1)
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ مُنَخَّلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قالَ : «أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ مُحَمَّدٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ بِمُوالاةِ عَلِيٍّ»ف-َ «اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا» مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ «كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ» .(2)
فأصل الرواية واحد ، وهي ما رواه جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، ولكن سقط من رواية الكافي قوله : «فذلك تفسيرها في الباطن» ، وهذا ما سبّب توهّم التحريف . وعلى فرض تعدد الرواية فإنّ المراد من رواية الكافي هو التفسير ، بقرينة رواية تفسير العيّاشي ، ولكن لم تنقل بقرائنها فأوهمت التحريف .
لأجل معرفة بعض الجهات الأُخرى المتعلّقة بهذه الروايات ، ومعرفة تأريخها ، لابدّ من بحث الروايات من جهة مصادرها الأصليّة التي روى الكليني أو أحد مشايخه الذين تقدّموه هذه الروايات عنها . وسنجعل البحث فيها ضمن أقسام ، فنقول :
نجد في أسانيد أربع من الروايات المدّعى دلالتها على التحريف(3) اسم «المنخّل» ، وهو «المنخّل بن جميل الأسدي بيّاع الجواري» ، والسند في ثلاث منها واحد ،
ص: 349
وهو : «عن محمَّد بن سنان ، عن عمَّار بن مروان ، عن منخَّل ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام » ، والسند الرابع : «أحمد بن إدريس ، عن محمَّد بن حسَّان ، عن محمَّد بن عليّ ، عن عمَّار بن مروان ، عن منخَّل ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام » .
ففي الجميع روى المنخّل عن جابر ، والذي يراجع كتب الفهارس يجد في ترجمة جابر ما يلي :
جابر بن يزيد أبو عبد اللّه ، و قيل : أبو محمّد الجعفي ، عربيّ قديم . نسبه: ابن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مرار بن جعفي. لقي أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهماالسلام و مات في أيّامه سنة ثمان و عشرين و مئة. روى عنه جماعة غمز فيهم و ضعفوا ، منهم : عمرو بن شمر ، ومفضّل بن صالح ، ومنخّل بن جميل ، ويوسف بن يعقوب. وكان في نفسه مختلطاً ، و كان شيخنا أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله ينشدنا أشعاراً كثيرة في معناه تدلّ على الاختلاط ، ليس هذا موضعاً لذكرها ، وقلّ ما يورد عنه شيئا في الحلال والحرام.
له كتب منها : التفسير أخبرناه أحمد بن محمّد بن هارون ، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن خاقان النهدي ، قال : حدثنا محمّد بن عليّ أبو سمينة الصيرفي ، قال : حدّثنا الربيع بن زكريا الورّاق عن عبد اللّه بن محمّد عن جابر به. و هذا عبد اللّه بن محمّد يقال له الجعفي ضعيف ، وروى هذه النسخة أحمد بن محمّد بن سعيد عن جعفر بن عبد اللّه المحمّدي عن يحيى بن حبيب الذراع عن عمرو بن شمر عن جابر.
وله كتاب النوادر أخبرنا أحمد بن محمّد الجندي ، قال: حدثنا محمّد بن همّام ، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك ، قال: حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، قال: حدّثنا محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن المنخّل بن جميل عن جابر به .
وله كتاب الفضائل ، أخبرنا أحمد بن محمّد بن هارون عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن محمّد بن أحمد بن الحسن القطواني عن عباد بن ثابت عن عمرو بن شمر عن جابر به. و كتاب الجمل ، وكتاب صفّين ، وكتاب النهروان ، وكتاب مقتل أمير المؤنين عليه السلام ، وكتاب مقتل الحسين عليه السلام ، روى هذه الكتب الحسين بن الحصين
ص: 350
العمي ، قال : حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن معلّى ، قال : حدثنا محمّد بن زكريا الغلابي ، وأخبرنا ابن نوح عن عبد الجبّار بن شيران الساكن نهر خطي عن محمّد بن زكريا الغلابي عن جعفر بن محمّد بن عمّار عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر بهذه الكتب . وتضاف إليه رسالة أبي جعفر إلى أهل البصرة وغيرها من الأحاديث والكتب وذلك موضوع واللّه أعلم .(1)
وجاء في ترجمة جابر الجعفي من فهرست الشيخ الطوسي قدس سره :
جابر بن يزيد الجعفي ، له أصل ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن المفضّل بن صالح ، عنه . ورواه حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان ، عن جابر .
وله كتاب التفسير ، أخبرنا به جماعة من أصحابنا ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي علي بن همّام ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، ومحمّد بن جعفر الرزّاز ، عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن منخّل بن جميل ، عن جابر بن يزيد .(2)
وقال النجاشي في ترجمة المنخّل :
منخّل بن جميل الأسدي بيّاع الجواري ، ضعيف ، فاسد الرواية . روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، له كتاب التفسير، أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد ، قال : حدّثنا حمزة ، قال : حدّثنا عليّ بن عبد اللّه بن يحيى ، قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبد اللّه ، قال : حدثنا أبي ، عن محمّد بن سنان ، عن منخّل .(3)
وقال الشيخ في الفهرست :
منخّل بن جميل ، له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن (محمّد بن الحسن) الصفّار ، والحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن المنخّل بن جميل . و رواه حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه .(4)
ص: 351
وهنا نقاط جديرة بالبحث وتسليط الأضواء عليها ، وهي :
أ . قال الشيخ قدس سره في ترجمة المنخّل : «له كتاب» ، ولم يذكر عنوان الكتاب ، وأمّا النجاشي قدس سرهفقال في ترجمته : «له كتاب التفسير» .
ب . مجموع الروايات المروية في الكافي عن المنخّل ستّ روايات ، أربع منها في هذا الباب ، وواحدة في باب «أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلاّ الأئمّة عليهم السلام» ، والأُخرى في باب «ذكر الأرواح التي في الأئمّة عليهم السلام» .
ج . إنّ الروايات المروية في الكافي عن المنخّل تنتهي جميعاً إلى جابر الجعفي .
د . اشتراك أسانيد أربع من الروايات الستِّ المروية في الكافي عن المنخّل في هذا المقطع من السند : «عَن مُحَمَّدِ بنِ سِنانٍ عَن عَمَّارِ بنِ مَروانَ عَن مُنَخَّلٍ عَن جابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ عليه السلام » ، والسند الخامس «عَن مُحَمَّدِ بنِ سِنانٍ عَن عَمَّارِ بنِ مَروانَ عَن مُنَخَّلٍ عَن أَبِي عبد اللّه عليه السلام » ، والسند السادس «عَن مُحَمَّدِ بنِ حسّان عَن محمّد بن عليّ عن عَمَّارِ بنِ مَروانَ عَن مُنَخَّلٍ عَن جابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ عليه السلام » ، فالأسانيد الستُّ أجمع مشتركة في روايتها عن «عَمَّارِ بنِ مَروانَ عَن مُنَخَّلٍ» .
ه- . إنّ جابر الجعفي له كتب منها كتاب التفسير ، وقد رواه المنخّل كما تقدم عن الشيخ في الفهرست .
فالذي يظهر من القرائن ويقوى في الظنّ جدّاً أنّ المصدر الأصلي لهذه الروايات هو كتاب واحد وهو كتاب التفسير لجابر بن يزيد الجعفي ، ثمّ رواها المنخّل في كتابه التفسير أيضاً . والذي يشهد لذلك أُمور :
الأوّل : إنّ المنخّل هو الراوي لكتاب التفسير المنسوب لجابر ، كما صرّح به الشيخ في الفهرست بقوله :
... له كتاب التفسير ، أخبرنا به جماعة من أصحابنا ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلّعُكبري ، عن أبي علي بن همّام ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، ومحمّد بن جعفر الرزّاز ، عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن
ص: 352
منخّل بن جميل ، عن جابر بن يزيد .
الثاني : عدم رواية الشيخ الكليني قدس سره عن المنخّل بواسطة راوٍ غير «عمَّار بن مروان» ، وهذا يعني أنّ «عمّار» راوٍ لتراث المنخّل الراوي لتفسير جابر .
الثالث : شهرة كتاب التفسير لجابر كما تدلّ عليه عبارة الشيخ الطوسي حيث قال :
له كتاب التفسير ، أخبرنا به جماعة من أصحابنا ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التّلعُكبري ... .
إذ إنّ رواية جماعة من الأصحاب لكتاب رجل - وهو جابر الجعفي - دليل على معروفيّة الكتاب ، وشهرته بين الأصحاب كما لا يخفى .
الرّابع : إنّ الروايات المروية عن المنخّل وردت في موضع واحد من الكافي وهي متتالية تقريباً ، فإن كانت من مصادر أُخرى فمن البعيد جداً أن يجمعها الشيخ الكليني قدس سرهفي موضع واحد ، خصوصاً مع الطعن في المنخّل ؛ فإنّ جمعها في موضع واحد مضرّ فضلاً عن أن يكون نافعاً .
وبهذا يظهر وجه اعتماد الشيخ الكليني قدس سره - الذي هو «شيخ أصحابنا في وقته بالري ، ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث ، وأثبتهم»(1) - على كتاب المنخّل أو كتاب جابر - والرواية عنه ، فإنّ وجود «المنخّل بن جميل» في أسانيد هذه الروايات غير مضرّ بها بعد شهرة الكتاب وكثرة نسخه ، فكما نعتمد اليوم على كتاب الكافي المطبوع في بيروت إذا عرفنا صحّة الطبعة حتّى إذا كان الناشر له مسيحياً كذاباً ، كذلك اعتمد الكليني قدس سره على نسخة كتاب جابر المروية عن المنخّل .
نعم ، قد يكون الكتاب المشهور في نفسه ضعيفاً من بعض الجهات ، وهذا بحث آخر ، فإنّ اعتماد الكليني قدس سره على هذا العدد القليل من روايات الكتاب دليل على عدم قبوله لجميع الكتاب . وأمّا سبب قبوله لهذا المقدار فلعلّه لدلالة القرائن وتأييد الشواهد لها ؛ فإنّنا نجد روايات كثيرة رواها الشيخ الكليني عن جابر الجعفي عن
ص: 353
طريق غير المنخّل ، حتّى بلغ مجموع رواياته في الكافي (158) رواية ، موزَّعة على أجزائه بالشكل التالي : ج 1 (30) رواية ، ج 2 (39) رواية ، ج 3 (31) رواية ، ج 4 (13) رواية ، ج 5 (15) رواية ، ج 6 (12) رواية ، ج 7 (4) رواية ، ج 8 (14) رواية ،
وهذا ما يشير إلى اعتماد الشيخ الكليني على كتب جابر المختلفة ، وروايته عنه في أبواب متعدّدة من الكافي ، بخلاف روايات المنخّل .
كما أنّ إيراد الروايات في كتاب التفسير لجابر(1) ، ثمّ كتاب التفسير للمنخّل(2) قرينة أُخرى على كون هذه الروايات تفسيرية ، وعلى الأقلّ في خمس من الروايات المذكورة والمروية عن جابر . ولعلّ هذه القرينة أقوى ممّا تقدّم من فهم الشيخ الكليني قدس سره لها بما ذكر ؛ فإنّ جابر والمنخّل متقدّمان زماناً على الشيخ الكليني قدس سره ، بل هما معاصران للأئمّة عليهم السلام ، فلا ريب في أنّ فهمهما لها موافق للفهم السائد في زمان صدور الحديث ، ونابع من القرائن والمرتكزات العرفية آنذاك .
بمراجعة الروايات المتقدّمة نجد أنّ الروايات التي ورد في أسانيدها «المعلّى بن محمّد» هي خمس روايات(3) ، تشترك جميعاً في جهة واحدة هي أنّها مرويّة عن «الحسين بن محمَّد عن معلَّى بن محمَّد» ، كما أنّ اثنتين منها متّحدة سنداً : «عن معلَّى بن محمَّد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام »(4) .
ولنلاحظ الآن ما ذكره علماؤنا في فهارسهم عن المعلّى بن محمّد ، فقد قال
ص: 354
النجاشي في ترجمته ما يلي :
معلّى بن محمّد البصري أبو الحسن ، مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة . له كتب ، منها : كتاب الإيمان ودرجاته وزيادته ونقصانه ، كتاب الدلائل ، كتاب الكفر ووجوهه ، كتاب شرح المودّة في الدين ، كتاب التفسير ، كتاب الإمامة ، كتاب فضائل أمير المؤنين عليه السلام ، كتاب قضاياه عليه السلام ، كتاب المروءة (المروة) ، كتاب سيرة القائم عليه السلام . أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر عن معلّى بن محمّد .(1)
وقال الشيخ في الفهرست :
معلّى بن محمّد البصري ، له كتب منها : كتاب الإيمان ودرجاته ومنازله وزيادته ونقصانه ، وكتاب الكفر ووجوهه ، وكتاب الدلائل ، وكتاب الإمامة ، وغير ذلك . أخبرنا بها جماعة عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري ، عن المعلّى بن محمّد البصري . وروي عنه كتاب الملاحم عن محمّد بن جمهور العمي .(2)
وبه يتضح أنّ المعلّى له جملة من الكتب أحدها كتاب التفسير ، وأنّه رواه جماعة كما ذكر الشيخ الطوسي قدس سره . والظاهر أنّ هذه الروايات مرويّة عن هذا الكتاب . نعم ما كان منها بهذا السند : «عن معلَّى بن محمَّد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام »(3) فيحتمل أن يكون من كتاب عليّ بن أبي حمزة البطائني ، فإنّ له كتباً عديدة ، كما صرّح به النجاشي في فهرسته حيث قال :
عليّ بن أبي حمزة - واسم أبي حمزة سالم - البطائني أبو الحسن مولى الأنصار ، كوفي ، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم ، وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة ، روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، وروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ وقف ، وهو أحد عمد الواقفة . وصنّف كتبا عدّة ، منها : كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة ، كتاب التفسير
ص: 355
وأكثره عن أبي بصير - كتاب جامع في أبواب الفقه .
أخبرنا محمّد بن جعفر النحوي في آخرين ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن غالب ، قال : حدّثنا علي بن الحسن الطاطري ، قال : حدّثنا محمّد بن زياد عنه . وأخبرنا محمّد بن عثمان بن الحسن ، قال : حدثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدثنا عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك أبو العبّاس النخعي ، عن محمّد بن أبي عمير وأحمد بن الحسن الميثمي ، جميعاً عنه بكتبه .(1)
وهو صريح في أنّ له كتباً أحدها كتاب التفسير ، وأنّ هذا الكتاب أكثره عن أبي بصير ، والروايات التي هي محلّ الكلام من هذا القبيل ؛ فثلاث منها مروية عن «عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام »(2) ، وقد رويت اثنتان من هذه الثلاث عن المعلّى(3) ، فإمّا أن تكون هاتان الروايتان من كتاب المعلّى أو من كتاب عليِّ بن أبي حمزة البطائني .
الروايات التي وردت عن أبي حمزة - وهو الثمالي - خمس روايات ، إحداها(4) لا توهم التحريف إلاّ لمن لا خبرة له باللّغة العربية كما سبق ، وأربع كانت محلّ الكلام(5) ، وإليك فيما يلي ما قاله النجاشي قدس سره في حقّه :
ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي ، واسم أبي صفية دينار ، مولى ، كوفي ، ثقة ، وكان آل المهلّب يدَّعون ولاءه وليس من قبيلهم ، لأنّهم من العتيك ، قال محمّد بن عمر الجعابي : ثابت بن أبي صفية مولى المهلب بن أبي صفرة ، وأولاده نوح ومنصور وحمزة قتلوا مع زيد ، لقي عليّ بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد اللّه وأبا الحسن عليهم السلام ،
ص: 356
وروى عنهم ، وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث . وروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : "أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه" . وروى عنه العامّة ، ومات في سنة خمسين ومئة .
له كتاب تفسير القران ، أخبرنا عدة من أصحابنا ، قالوا : أخبرنا أبو بكر محمّد بن عمر بن سلم بن البراء بن سبرة بن سيّار التميمي المعروف بالجعابي ، قال : حدّثنا أبو سهل عمرو بن حمدان في المحرّم سنة سبع وثلاثمئة ، قال : حدّثنا سليمان بن إسحاق بن داوود المهلّبي قدم علينا البصرة سنة سبع وستين ومئتين ، قال : حدّثنا (حدّثني) عمّي عبد ربه ، قال : حدّثني أبو حمزة بالتفسير .
وله كتاب النوادر رواية الحسن بن محبوب ، أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا أبي عن سعد عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة به .
وله رسالة الحقوق عن عليّ بن الحسين عليه السلام ، أخبرنا أحمد بن علي ، قال : حدّثنا الحسن بن حمزة ، قال : حدثنا عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهماالسلام .(1)
وهنا عدّة نقاط جديرة بالتأمّل :
أ . إنّ أبا حمزة جليل القدر جدّاً ، بل كان في زمانه مثل سلمان في زمانه ، كما في الرواية .
ب . له عدّة كتب منها كتاب التفسير .
ج . قال النجاشي في شأن كتاب التفسير : «أخبرنا عدّة من أصحابنا» ، وهو يفيد معروفية الكتاب وشهرته بين الأصحاب .
د . إنّ الروايات التي هي محلّ الكلام والتي وقع في أسانيدها أبو حمزة أربع روايات ، ثلاث منها بسند واحد هو : «أحمد بن مهران عن عبد العظيم الحسني عن
ص: 357
محمَّد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام »(1) ، والرابعة عن أبي يحيى عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) .
ه- . إنّ جميع الروايات المروية في الكافي وغيره والتي وقع في أسانيدها عبد العظيم الحسني وأبو حمزة ، أربع روايات ، ثلاث منها في الكافي وهي التي تقدّمت ، والرابعة في كمال الدين(3) . وعبد العظيم الحسني - أيضا - جليل القدر جدّاً ، وهذا دليل آخر على نقاوة تراث أبي حمزة ؛ بدليل رواية الأجلاّء له .
و . إنّ الرواية الرابعة من روايات أبي حمزة ، والمروية عن أبي يحيى عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام (4) ليست تفسيرية ، بخلاف الروايات الثلاث المروية عن عبد العظيم(5) ، فإنّها جميعاً روايات تفسيريّة ، وهذا ما يشير إلى أنّ عبد العظيم الحسني رواها من كتاب التفسير لأبي حمزة الثمالي(6) ، وهو دليل آخر على معروفية الكتاب وشهرته .
وبهذا يتّضح أنّ المصدر الأصلي للروايات المرويّة عن أبي حمزة الثمالي هو كتابه التفسير ، وأنّ هذا الكتاب كان مشهوراً معروفاً ، وأنّ عبد العظيم الحسني روى ثلاثاً من
ص: 358
هذه الروايات عنه .
وأمّا الرواية التي رواها عبد العظيم الحسني عن بكَّار عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام (1) ، فمصدرها الأصلي هو كتاب التفسير لجابر بن يزيد الجعفي ، وهو كتاب مشهور كما تقدّم .
نجد في أسانيد ستٍّ(2) من الروايات المذكورة اسم «محمّد بن الفضيل» ، في أربع منها «محمَّد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام »(3) ، وفي اثنين منها : «محمَّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام » . فأمّا التي عن محمّد بن الفضيل فهي من كتابه ، وأمّا الأُخريان فإحداهما عن «عليّ بن محمَّد عن بعض أصحابنا عن ابن محبوب عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام »(4) ، والأُخرى عن «محمَّد عن أحمد بن محمَّد عن ابن محبوب عن محمَّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام »(5) ، وهما مشتركتان في روايتهما عن الحسن بن محبوب .
ولنر ما قيل في ترجمة محمّد بن الفضيل ، والحسن بن محبوب ، قال النجاشي قدس سره في ترجمة محمّد بن فضيل :
محمّد بن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي أبو جعفر الأزرق ، روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهماالسلام ، له كتاب و مسائل . أخبرنا علي بن أحمد ، قال : حدثنا ابن الوليد عن الحميري ، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن
ص: 359
فضيل بكتابه. و هذه النسخة يرويها جماعة .(1)
وقال الشيخ في ترجمة ابن محبوب :
الحسن بن محبوب السرّاد ويقال له : الزراد ، يكنّى أبا علي ، مولى بجيلة كوفي ثقة روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وروى عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام . وكان جليل القدر يعدّ في الأركان الأربعة في عصره . له كتب كثيرة منها : كتاب المشيخة ، كتاب الحدود ، كتاب الديّات ، كتاب الفرائض ، كتاب النكاح ، كتاب الطلاق ، كتاب النوادر نحو ألف ورقة . وزاد ابن النديم : كتاب التفسير ، كتاب العتق ، رواه أحمد بن محمّد بن عيسى وغير ذلك . أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب .
وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ومعاوية بن حكيم والهيثم بن أبي مسروق ، كلّهم عن الحسن بن محبوب . وأخبرنا أحمد بن محمّد بن موسى بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن جعفر بن عبيد اللّه عن الحسن بن محبوب . وأخبرنا بكتاب المشيخة قراءة عليه أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عن الحسن بن محبوب . وله كتاب المراح ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد عن يونس بن علي العطّار ، عن الحسن بن محبوب .(2)
ومن مجموع ما ذُكِرَ في ترجمتهما يتّضح ما يلي :
أ . إنّ محمّد بن الفضيل يروي عن الإمامين الكاظم والرضا عليهماالسلام .
ب . إنّ لمحمّد بن الفضيل كتاب ، ومسائل .
ج . إنّ الحسن بن محبوب يروي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وعن ستين رجلاً من
ص: 360
أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام .
د . إنّ الحسن بن محبوب له كتب كثيرة ، منها «كتاب التفسير» .
فالذي يراجع هاتين الروايتين يجد أنّهما مرويتان عن الإمام الكاظم عليه السلام ، فالذي يقوى في الظن أنّ المصدر الأصلي لإحداهما هو كتاب المسائل لمحمّد بن الفضيل ، إذ إنّ فيها : «عن محمَّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : سألتُهُ عن قَولِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ .. .»(1) ، ثمّ رواها عنه ابن محبوب في كتابه التفسير . فالمصدر الذي اعتمده الشيخ الكليني قدس سره إمّا أن يكون هو كتاب المسائل لمحمّد بن الفضيل ، أو كتاب التفسير لابن محبوب .
وأمّا الرواية الأُخرى(2) فقد تقدّم أنّها لا تَمتُّ إلى التحريف بصِلة ، وأنّ أبناء اللغة العربية لا يفهمون منها التحريف بالمرّة . نعم لم يتّضح لي مصدرها ، ولعلّه أحد كتب ابن محبوب .
وبهذا يتمّ البحث في مصادر جميع الروايات المذكورة ، وبه يتّضح أنّ أكثرها مرويّة في كتب التفسير ، وهو قرينة مهمّة على عدم إرادة التحريف منها .
كما ينقشع الظلام ويرتفع الإبهام عن سبب اعتماد الشيخ الكليني قدس سره على هذه الروايات مع الطعن في بعض رواتها ؛ فإنّها مرويّة في كتب معروفة ومشهورة ، ونقل الراوي الضعيف للمتن المشهور غير مضرّ بالمتن ، فإنّه نظير نقل أحد النواصب أو الكفّار مع كونه من الكذّابين أو الوضّاعين روايةً عن كتاب مشهور- كالكافي - في مقالة له أو في كتابه ، فإنّنا نعتمد على هذا النقل إذا ما عرفنا صحّته . فكذا اعتماد الشيخ الكليني على هذه الروايات ؛ فإنها من كتب مشهورة ، أو توجد القرائن على صحّتها .
ص: 361
اختلف المحقّقون في أُسلوب مواجهتهم لهذه الروايات - بسبب اختلافهم في فهمها - إلى مناهج ثلاث ، تبنّى الأوّل منها الأخباريّون ، وتبنّى الثاني والثالث منها علماؤنا الأصوليّون ، وهي كالآتي :
1 - حملها على المعنى المتبادر منها في زماننا - وهو التحريف - لا على المعنى المتبادر منها في زمان صدورها بملاحظة ما يكتنفها من القرائن والمرتكزات ، وهذا ما سلكه بعض الأخباريّين كالمحدّث النوري قدس سره . وقد تبيّن من خلال عرضنا المتقدّم عدم سلامة هذا المنهج ، وأنّ هذا الفهم للحديث هو فهم خاطئ .
2 - حمل الروايات المذكورة على التفسير فيما لو قبلت الحمل ، وردّ الباقي . وممّن اختار هذا المنهج هو السيّد الخوئي قدس سره ، حيث قال :
إنّ بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه ، فلابدّ من حمل هذه الروايات على أنّ ذكر أسماء الأئمّة عليهم السلام في التنزيل من هذا القبيل ، وإذا لم يتمّ هذا الحمل فلابدّ من طرح هذه الروايات ؛ لمخالفتها للكتاب والسنّة والأدلّة المتقدّمة على نفي التحريف . وقد دلّت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسنّة ، وأنّ ما خالف الكتاب منها يجب طرحه ، وضربه على الجدار .(1)
لكن لم يذكر وجه ودليل الحمل المذكور ؛ لتسكن وتطمئنّ إليه النفس ، واستظهار أو ترجيح أحد المعاني بحاجة إلى مرجّح ، وإلاّ فلا يكون مقنعاً للمخاطب حتّى لو كان صحيحاً .
3 - ردّ هذه الروايات بتضعيف أسانيدها ، وهذا المنهج مبنيّ على تسليم دلالة الروايات المذكورة على التحريف ، وقد تبيّن ممّا ذكرناه عدم دلالتها عليه . وممّن سلك هذا المنهج جملة من المحقّقين ، ومنهم السيّد علي الميلاني في كتابه : التحقيق
ص: 362
في نفي التحريف ، حيث حاول ردّ أو تضعيف الروايات المذكورة ، فقال :
روايات الشيعة في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى قسمين : الأوّل : الروايات الضعيفة أو المرسلة أو المقطوعة . والظاهر أنّ هذا القسم هو الغالب فيها ، ويتّضح ذلك بملاحظة أسانيدها ... .(1)
وهذا المسلك مبنيّ على تسليم دلالة الروايات المذكورة على تحريف الكتاب العزيز ، وإلاّ فلو لم تكن دالّة عليه فلا داعي لردّها ، وقد اتّضح عدم دلالتها عليه .
نعم ، نحن لا ندّعي صحّة جميع ما في كتاب الكافي ، وإنّما نقول : إذا دلّت الشواهد والقرائن على مخالفة خبرٍ للكتاب أو السنّة أو لروح الشريعة المقدّسة ، رددناه وحكمنا عليه بعدم الحجّية . وعليه فإن كانت الروايات المذكورة - أو بعضها - دالّة بحسب القرائن والشواهد على التحريف ، فإنّه لا مناص من القول بعدم حجّيتها ؛ لما ذكرناه من عدم انسجام القول بالتحريف مع روح الشريعة والروايات الأُخرى .
4 - المنهج الذي سلكناه ؛ وهو فهم الروايات وفقاً للقرائن الموجودة ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما له من أثر على فهمها ، وملاحظة مصادرها ، وانتهينا بالتالي إلى أنّ هذه الروايات تفسيرية ، ولا تَمتُّ إلى التحريف بصِلة .
اتّضح ممّا تقدّم أنّ المراد من روايات الطائفتين الاُولى والثانية هو التفسير ، وأنّ المراد من روايات الطائفة الثالثة هو التفسير أيضاً مع بيان أنّه من التفسير الذي نزل به الوحي أو المعبّر عنه ب-«الوحي التفسيري» ، وأمّا روايات الطائفة الرابعة فهي من اختلاف القراءات ، ولا دلالة فيها على التحريف بتاتاً ، كما أنّ روايات الطائفة الخامسة دالّة على التحريف المعنوي للقرآن ، لا التحريف اللفظي ، وهو ثابت قطعاً ، وأمّا روايات الطائفة السادسة فهي لبيان مضامين القرآن وتصنيف الآيات القرآنية حسب المعنى ،
ص: 363
ولا تمتُّ إلى التحريف بصلة ، وأمّا روايات الطائفة السابعة فإنّه قد وقع فيها تصحيف أوهم التحريف ، وقد رويت في مصادر أُخرى من دون تصحيف .
كما اتّضحت جملة أُمور هي كالتالي :
1 - إنّ فهم الحديث فهماً صحيحاً يتوقّف على ملاحظة جملة أُمور ، منها :
أ . ملاحظة القرائن التي تحفّ الكلام من الحاليّة والمقاليّة والمرتكزات العرفيّة وغيرها ؛ لاعتماد العقلاء على مثل تلك القرائن أثناء محاوراتهم ، وقيام القرائن مقام العبارات الموضّحة والمبيّنة للمراد .
ب . إنّ طول الفاصل الزمني بين صدور الكلام وبين السامع له أثر على خفاء القرائن المكتنفة للحديث .
ج . ممّا يمكن أن يستكشف به مراد المتكلّم هو فهم أصحاب الأئمّة عليهم السلام ، والعلماء المقاربين لزمان الأئمّة عليهم السلام ؛ لقربهم من تلك القرائن والأجواء والفهم العرفي السائد آنذاك .
د . أن يكون فهم الحديث منسجماً مع الأحاديث الأُخرى ، وأنّ فهمه في معزل عن الأحاديث الأُخرى فهم خاطئ ، فإنّ الأحاديث يفسّر بعضها بعضاً .
2 - إنّ مصادر هذه الروايات التي اعتمد عليها الشيخ الكليني قدس سره واضحة ، وغالبها كتب تفسير ، وهذه قرينة مهمّة على أنّ المراد من هذه الروايات هو التفسير ، لأنّ هؤلاء الرواة الذين كتبوا هذه الكتب معاصرون للأئمّة عليهم السلام ، فهم يفهمون الروايات وفقاً للقرائن الحالية والمقالية والمرتكزات العرفية السائدة آنذاك .
3 - إنّ الشيخ الكليني قدس سره من علماء أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ، وهو من علماء زمان الغيبة الصغرى ، فهو من المقاربين لزمان صدور الحديث ، ومن أجلاّء العلماء والمحدّثين الذين كانوا في بغداد - التي تعتبر أهمّ مدينة علميّة في العالم الإسلامي آنذاك - وكان معاصراً للنوّاب الأربعة للإمام الحجّة عليه السلام ، فلا ريب أنّ فهمه كان يبتني على القرائن السائدة آنذاك ، خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار منهجه
ص: 364
في الاعتماد على الروايات ؛ وهو مسلك الوثوق ، فما كان له شواهد من الكتاب الكريم والسنّة الشريفة أخذ به واعتمد عليه ، وما خالف الكتاب والسنّة والشواهد لم يعتمد عليه ولم ينقله في كتابه الكافي .
4 - إنّ الشيخ الكليني أورد الروايات المذكورة في باب عنوانه «باب فيه نكت و نُتَف من التنزيل في الولاية» ، ولم يورد شيئاً منها في «كتاب فضل القرآن» بأبوابه المتنوّعة والمتعدّدة ، وهذا دليل على أنّه لم يفهم منها تحريف القرآن أصلاً ، وإلاّ لأوردها أو بعضها في أبواب «كتاب فضل القرآن» ، وإنّما فهم منها التفسير .
5 - إنّ الروايات المشابهة لهذه الروايات والواردة في الأبواب والكتب الأُخرى تؤيّد عدم إرادة التحريف من هذه الروايات .
6 - إنّ اهتمام أهل البيت
عليهم السلام بالكتاب العزيز واستدلالهم بالآيات الكريمة في المواضع المختلفة يؤيّد عدم إرادتهم التحريف .
7 - لو كان المراد من هذه الطائفة من الأخبار هو التحريف لاعترض عليهم الناس ، خصوصاً مع ملاحظة اهتمام المسلمين على مدى العصور بالقرآن الكريم ، مع أننّا لا نجد في شيء من الروايات اعتراض المسلمين على الأئمّة عليهم السلامفي ذلك .
8 - ملاحظة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع آنذاك يدلّ بوضوح على تفضيل استخدام التفسير المزجي للقرآن الكريم .
9 - القرائن التاريخية والحديثية تدلّ على نزول الآيات وتفسيرها وتأويلها على النبي الأعظم صلى الله عليه و آله ، وأنّ الروايات التي صرّحت بنزول الآية هكذا يراد بها نزول تفسيرها وتأويلها .
10 - الدقّة في مضامين الروايات ترشدنا إلى أنّ بعض ما ادّعي دلالته على التحريف ليس له دلالة على ذلك بالمرّة .
11 - إنّ منشأ شبهة التحريف في بعض الروايات هو التصحيف الحاصل فيها ، وما وقع فيه تصحيف لا يمكن نسبته لأهل البيت عليهم السلام ، فلابدّ من الاطمئنان من صحّة
ص: 365
نسخة الرواية قبل البحث في معناها .
فمن مجموع هذه الأُمور يحصل لنا الاطمئنان بإرادة التفسير من هذه الروايات ، وبيان وجه من وجوه الآيات الواردة فيها ؛ وهو الوجه المتعلّق بولاية أمير المؤمنين عليه السلام أو أهل البيت عليهم السلام .
وأخيراً نسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يوفّقنا للذبّ عن كتابه العزيز ، وعن مذهبنا الحقّ ورواياته الشريفة ، فإنّهما أساس ديننا ، ومعارفنا ، وأحكامنا ، فما قال به أهل البيت قلنا ، وما أنكروه أنكرنا ، ونسأل اللّه السداد إنّه خير ناصر ومعين .
ص: 366
منهج تفسير القرآن بالقرآن
في مرويات الكافي للشيخ الكليني
د . سيروان عبد الزهرة هاشم(1)
إذا كان النصّ القرآني معجزة السماء الكبرى إذ تتجلّى فيه أروع مستويات الخطاب اللغوي وأجمل بنائيات الفنّ المقالي، فإنّه من الحتمي - والحال هذه - أن ينطوي على عنصر التكامل والتوحّد المضموني والربط الأجزائي بين سوره عموما، وآياته داخل تلك السور خصوصا ، ومفرداته ضمن الآية الواحدة بشكلٍ أخصّ ؛ ذلك بأنّ عامل التكامل في الخطاب - سواء أكان ربّانيا أم بشريا - هو المرتكز الأساس في تنقية الدلالة وبناء حيثياتها لإيصالها للمتلقّي .
ولمّا كان الإعجاز يمثّل جوهر القرآن، كان التكامل في التعبير المقدّس أساسا لذلك الإعجاز ، فالنصّ يأخذ بعضه ببعض، ويشدّ بعضه هذا إلى بعضه الآخر، حتّى يغدو صورة جمالية غاية في الدقّة والروعة ؛ إذ نلحظ أنّ بداية السورة مرتبطة بنهايتها محورا وموضوعا وخطابا ، بل نجد أنّ نهاية السورة لها صلة بمفتتح السورة التي تليها .
أمّا نسق النصوص القرآنية داخل السورة الواحدة، فهو ظاهر لكلّ ذي نظر وتأمّل، فالآيات تتكامل معا مضمونيا وبنائيا في السياق العامّ للسورة الواحدة، حتّى لكأنّك
ص: 367
تشعر بأنّ السورة تتحدّث عن موضوعٍ واحد .
والأظهر أنّ هذا الملحظ هو الذي دفع بعض العلماء إلى القول - وهم في صدد بيانهم لداعي تسمية القرآن ب «القرآن» - بأنّ هذه التسمية مُشتقّة من الفعل «قَرَنَ»، حيث نُقل عن الأشعري قوله:
هو مشتقّ من قرنت الشيء بالشيء؛ إذا ضممت أحدهما إلى الآخر، وسُمّي به لقران السور والآيات والحروف فيه(1) .
ويرى الفرّاء بأنّه:
مشتقّ من القرائن ؛ لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا، ويشابه بعضها بعضا، وهي قرائن(2) .
فلمّا كانت آياته يشابه بعضها بعضا، كانت كلّ واحدة قرينة على الأُخرى ، فكلّهن نظائر، ولهذا أصبحن قرائن(3) ، فكلّ واحدة دليل وقرينة على أُختها ، وهذا يعلّل لنا مدى تلمّس العلماء لهذه الظاهرة في التعبير القرآني، ومدى بيانها على نصوصه علنا وكشفاً .
من هنا ظهر ما يُدعى ب «بيان القرآن للقرآن» ، ويبدو أنّ عملية بيان هذا الإبهام تجري على نمطين في التعبير القرآني :
الأوّل: وهو أن ترد لفظة مبهمة في نصّ قرآني ويرد بيانها في ذات النصّ نفسه، أي يرد المبهم وإيضاحه في آية واحدة معا، كمجيء المطلق وبعده المقيّد في نصٍّ واحد، أو أن يأتي العامّ ومخصّصه في ذات الآية .
أمّا الثاني: فهو أن ترد لفظة مبهمة أو تركيب مبهم في نصٍّ قرآني، ويرد تفسيره وبيانه في نصٍّ قرآني منفصل عنه، سواء أكان في السورة ذاتها، أم في غيرها .
ص: 368
وهذا النمط الأخير هو ما يعنينا، وهو ما يصدق عليه في الوقت ذاته تسمية «منهج تفسير القرآن بالقرآن»، وهو عملية عرض ما أُبهم في النصّ القرآني على نصّ قرآني آخر؛ لورود بيان النصّ الأوّل وإيضاحه في ذلك النصّ الآخر، بغضّ النظر عن درجة إبهام النصّ الأوّل وطبيعته، فما زال النصّ الآخر كاشفا للأوّل، فهو تفسير له ، فقد ترد لفظة غامضة الدلالة - سواء كانت عامّة أم مطلقة أو مجملة - في موضعٍ من آيةٍ قرآنية، ويرد لها بيانٌ وكشفٌ في موضعٍ آخر من آيةٍ قرآنية أُخرى، وبإجراء عملية عرض المبهم على الواضح يتحقّق منهج تفسير القرآن بالقرآن .
ويعدّ منهج تفسير القرآن بالقرآن من أقدم المناهج التفسيرية، وأكثرها تطبيقا وانطباقا على حقيقة الدلالة المطلوبة(1) ؛ لأنّ كلام اللّه تعالى يُفسّر بعضه بعضا، والمتكلّم هو الأعلم بمراده ومضمون كلامه ، وما أبانه سبحانه بنفسه أولى بالقبول والانصياع ممّا أبانه الناس على مقدار عقولهم واجتهادهم في نطاق النصّ .
لهذا ينظر إلى منهج تفسير القرآن بالقرآن على أنّه المنهج الأصدق في التفسير والأكثر ثقةً، والأبعد عن مجانبة الحقيقة ؛ لأنّه صادر من الذات المقدّسة (المتكلّمة) ذاتها .
من هنا «حظي هذا المنهج باهتمامٍ واسعٍ، خاصّة عند المفسّرين في القرن الأخير ، بحيث اتّخذه بعض المفسّرين منهجا رئيسا لهم، كما يتّضح ذلك في تفسير الميزان للعلاّمة الطباطبائي ، وتفسير الفرقان للدكتور محمّد الصادقي الطهراني ، والتفسير القرآني لعبد الكريم الخطيب ، وآلاء الرحمان للبلاغي»(2)، والبيان للسيّد الخوئي، وغيرها .
ص: 369
أمّا ما يشغلنا من هذا الشأن فهو كتاب الكافي للشيخ الكليني، فقد كان هذا المدوّن من المدوّنات التي حظيت بتوظيف المرويات الحديثية في عملية تفسير ما أبهم من النصّ القرآني بالنصّ القرآني نفسه ، فعلى الرغم من أنّ كتاب الكافي للشيخ الكليني يعدّ مدوّنا روائيا ؛ إذ يمثّل أحد أقوى موارد المعرفة الشيعية في نطاق استنباط الأحكام الشرعية وتجلّيات التنظير الفقهي، حيث يركن إليه في كلّ شاردة وواردة لاستنقاء الدلالة الحكمية وإبرائها للنفس والذمّة ؛ فعلى الرغم من هذه النظرة التخصّصية فيه، فإنّه تعرّض في طيّات نصوصه إلى بيان بعض مبهمات النصّ القرآني .
إذ يورد الكليني نصّا روائيا لمعصومٍ ينطوي ذلك النصّ الروائي على منهج تفسير القرآن للقرآن ، فقد وظّف الكليني جملة من النصوص الروائية لبيان نصوص قرآنية أُخرى قد غمض معناها وأبهم المراد منها بدقّة، فكان توظيفه هذا عملاً تفسيريا محضا ، وقد نسب تلك النصوص جميعها إلى الأئمّة عليهم السلام ؛ لأنّهم النخبة الأكثر معرفةً والأعمق غوصا في مكنونات النصّ المعجِز واستجلاء دلالاته الخفية .
ويبدو أنّ الكليني بعمله هذا قد أضفى على سفره الثمين سمةً نفعيةً مزيدةً ؛ إذ من المتسالم عليه أنّ الكافي كتاب رواية وحديث، يستقي منه العلماء والمتبصّرون الأحكام الإلهيّة، ويبنون عليها استنتاجاتهم مشفوعة بالدليل وسبل الإقناع ، على حين أنّ النظرة إلى كتاب الكافي على أنّه مدوّن تفسيري ، أو بتعبير أدقّ مدوّن ينطوي على تفسير - فيما أخال - لم تكن ملحوظة فيه من قبل ، لهذا يمكن أن يُحسب لهذه النظرة حسابها في إعادة التفكير في تثمين كتاب الكافي على جهة تخصّصية واحدة فحسب .
لقد انطوى الكافي على جملة نصوص روائية مسندة إلى الأئمّة عليهم السلام ، جرى فيها
ص: 370
بيان إبهام موجود في آية قرآنية بآية قرآنية أُخرى منفصلة عنها ، ويبدو أنّ مردّ اعتماده في هذا البيان على مرويات الأئمّة يرجع إلى أنّ السنّة النبويّة تعدّ من التراكيب النصّية الشارحة لمبهم القرآن ؛ إذ تُبيّن وتُفصّل ما أبهم معناه فيه(1) ؛ «لأنّ الرسول وظيفته التبليغ والبيان»(2) .
فالتبليغ يؤدَّى بنقل النصّ المنزل إلى الناس ، والبيان يؤدَّى بإيضاح ما أراده سبحانه بالنصّ المُنزَل ، فإذا ما وقع فيه غموض كان الرسول صلى الله عليه و آله هو المُخوّل ببسط معناه وإزاحة اللثام عن دلالته ، وسند هذا التوكيل واضح في النصّ القرآني، وذلك في قوله تعالى: «وَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»(3) ، فنجد أنّ مهمّة الرسول صلى الله عليه و آله - تأسيسا على ما انطوت عليه هذه الآية من مضمون - هي تفصيل القرآن وتيسيره للفهم، سواء وقع ذلك البيان على اللفظ الغامض بتحديده وتشخيصه، أم كان موضعه الكلام الواضح ، فيزيده طواعية ويسرا فيُقرّبه للأذهان ويبسط فيه القول حتّى يكون حجّة على من يدّعي عدم الفهم لدلالة النصّ كاملة .
وفي نصٍّ آخر يقول سبحانه وتعالى : «وَ مَآ ءَاتَائِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»(4)، فنلحظ أنّ هذه الآية قد ألزمت الناس جميعا بوجوب الطاعة للرسول صلى الله عليه و آله ، بدلالة الأمرين: «فَخُذُوهُ» و«فَانْتَهُوا» ، فالأمر منه نافذ والنهي منه جارٍ على سائر الناس ، فإذا كان سبحانه قد عهد إلى الرسول صلى الله عليه و آله تكليفا - في آية النحل - إيضاح النصّ المقدّس للناس ، فإنّه قد أمر الناس بالمقابل - في آية الحشر - أن يتولّوا مهمّة الطاعة لما يفصّله الرسول صلى الله عليه و آله ، فتكون مسؤوليتهم التطبيق وأداء المطلوب منهم من دون جدل أو نقاش . وبناءً على دلالتي الآيتين يعدّ «كلّ ما
ص: 371
صحّ ثبوته عن الرسول قولاً وفعلاً حجّةً بنفسه كالقرآن الكريم»(1) .
من هنا جاز تفصيل مبهم القرآن بالسنّة التي تعني كلّ ما صدر عن النبيّ صلى الله عليه و آله من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ(2) ، ويدخل في سنّة الرسول صلى الله عليه و آله ما نقله الأئمّة المعصومون عليهم السلام عن الرسول صلى الله عليه و آله ، فهم حجّة في ذلك ؛ إذ يمكن لأقوالهم أن تفسّر المبهم الوارد في القرآن(3) .
و«يكفي إثبات الحجّية لها كونها مروية من طريقهم عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وصدورها عنهم باعتبارهم من الرواة الموثوقين»(4)، فقد يحدث أن تُساق رواية لمعصومٍ يفسّر بها نصّاً قرآنيا بنصٍّ قرآني آخر ، فيكون الإمام بهذا مستعملاً منهج تفسير القرآن بالقرآن ، وبناءً عليه يكون تفسيره جامعا بين منهجين من مناهج التفسير القرآني، ألا هما منهج تفسير القرآن بالقرآن ، ومنهج التفسير الروائي، أو ما يُسمّى ب «منهج التفسير الأثري» .
فأمّا تحقّق منهج تفسير القرآن بالقرآن؛ فلأنّ مضمون الرواية تنصّ على ورود إبهام في نصّ قرآني «النصّ الغامض»، والتقاط ما يفسّر ذلك الإبهام بنصٍّ قرآني آخر «النصّ الموضِّح» .
أمّا القول بأنّه منهج روائي؛ فلأنّ الرواية التي وقع فيها التفسير إنّما هي منقولة عن الأئمّة عليهم السلام ، وكل ما نُقل عن الأئمّة في نطاق تفسير القرآن يعدّ من باب المنهج الأثري أو الراوئي ، فالرواية من حيث المضمون هي من باب منهج تفسير القرآن بالقرآن، ومن جهة الحيثية في النقل هي من باب منهج التفسير الأثري .
من هنا نجد أنّ الكليني حينما أورد هذه النصوص التفسيرية عن الأئمّة عليهم السلام، كان
ص: 372
قد اتّبع منهجين من مناهج التفسير القرآني، لا منهجا واحدا، فالمرويات من حيث النقل «تفسيرا أثريا»، ومن حيث الدلالة التطبيقية لها «تفسيرا قرآنيا» .
ولمّا كان هذا المنهج التفسيري «تفسير القرآن بالقرآن» من أكثر المناهج التفسيرية وثوقا وصدقا، سنعمد في هذه الدراسة إلى استقراء كتاب الكافي لننتزع من طيّاته - على مقدار الوسع - المرويات التي استندت إلى هذا المنهج التفسيري؛ لبيان الحيثيات التي اتّبعها الأئمّة في استعمالهم لهذا المنهج، ومدى قدرتهم على ربط الآية بأُختها، وبيان ما غمض من النصّ من خلال عرضه على نصٍّ آخر، وخصوصا ما يتعلّق بدلالات الأحكام الشرعية ؛ وذلك إيماناً منهم بأنّ اللّه تعالى لا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال أن يُكلّف عباده بالمبهم ؛ ذلك بأنّ التكليف بالمبهم من المحال عقلاً ومنطقا ، فأنّى للمرء أن يعرف المراد ما لم تكن هناك وسيلة أو وساطة لوصوله إلى ذلك المراد .
من هنا تظهر أهمّية هذا النمط التفسيري في كتاب الكافي، مرتبطةً تلك الأهمّية بكتاب الكافي نفسه ، وتتّضح في ذات الوقت وظيفة الأئمّة عليهم السلام في إنقاذ الناس من قبضة الإبهام وتحريرهم إلى باحة الإيضاح واليقين، حتّى يجري عملهم على وفق المعرفة والوضوح، لا الإبهام والتردّد .
إذا كان النصّ القرآني قد بُني على أُسس المنظومة الكلامية للّسان العربي، وتأسّس على ثوابت الأُسلوبية العالية للغة العرب وقتذاك، فإنّ هذا يعني بالضرورة وجود علاقة جدلية في التعبير القرآني تربط بين الإبهام وبيان ذلك الإبهام ؛ إذ إنّ الإبهام وبيانه سنّة من سنن تداولية الخطاب العربي البليغ، وتأسيسا على هذا المضمون نشهد في التعبير القرآني المقدّس جملةً من المكوّنات الدلالية والوسائل المضمونية التي تعمل على أداء المعنى المبتغى لدى المتلقّي .
ص: 373
وتُصنّف هذه المكوّنات على وفق المراد منها في الخطاب اللغوي على صنفين : أحدهما يسير باتّجاه بناء دلالة الإبهام والغموض في النصّ، كأدوات إنشاء دلالة المجمل أو المطلق أو العامّ ووسائل تحقّقهما في الكلام ، وآخر يأخذ بيد السامع إلى نطاق البيان، فيسعى إلى تشخيص الدلالة وإنارة المسلك إليها؛ كي يقدّمها لذهن السامع وهي جلية الدلالة واضحة المعنى .
وإذا كان هذا الصنف يتقلّد وظيفة إنتاج الدلالة مع شرط الوضوح، فلا بدّ من أن تكون له وسائل وأدوات تعدّ مفاتيح يُتوسّل بها لبلوغ تلك الدلالة، منوطة بشرطها التي أُسّست عليه ، فكان من تلك الأدوات المرويات التي نُقلت عن الأئمّة عليهم السلام، حيث تعدّ هذه المرويات من الوسائل البيانية التي تُقيّض للسامع أو المتلقّي إمكانية نيل الوضوح من الكلام الإلهي، حتّى يقرّ على بيان ويرسي عند جلاء المعنى ، فيخرج من عالم الإبهام إلى حيز إضاءة الدلالة .
وتأسيسا عليه آمن الكليني في كتابه الكافي بأنّ الرواية تعدّ مفتاحا تفسيريا للكثير من الغموض الذي يعتري النصّ القرآني، فهي الوسيلة الأمثل في إيضاح ما غاب عن البيان في التعبير المقدّس ، لهذا عمد في سفره الكافي إلى توظيف جملة من المرويات لبيان الغموض الدلالي للنصّ القرآني ، فقد يرد إبهام في نصّ قرآني ينظوي على حكم شرعي يستدعي أن يأخذ به الناس ويلتزمونه ؛ لأنّه صادر عن الذات الإلهيّة المُشرّعة ، فكان على المتلقّي - والحال هذه - ضرورة معرفة المراد الدلالي لذلك الإبهام، وإلاّ بقي الأمر المكُلّف به غامضا عليه، ولربّما اضطرّ إلى ترك التكليف ؛ لعدم قدرته على تشخيص المطلوب .
لهذا أوكل سبحانه مهمّة بيان كتابه إلى الرسول والأئمّة عليهم السلام، ومن ثمّ أحال الأمر من بعدهم على نطاق الاجتهاد العقلي بناءً على استثمار مضامين تلك النصوص المروية عن الأئمّة والرسول صلى الله عليه و آله ، فضلاً عن اللجوء إلى المصدر التشريعي الأوّل، ألا وهو النصّ القرآني ذاته، فما عجز الوصول إلى معرفته من النصّ القرآني ذاته يُركن فيه إلى
ص: 374
الروايات، وهي المصدر التشريعي الثاني بعد المعجزة الكبرى «النصّ القرآني» ؛ ذلك بأنّ اللّه تعالى من المستحيل أن يكلّف الناس بما لا يطيقون معرفته ؛ إذ التكليف بالمبهم مستحيل عقلاً وعملاً كما قرّرنا .
من هنا نقول: إنّ اللّه سبحانه قد يحدث أن يورد لفظة مبهمة في نصٍّ قرآني تشريعي لا سبيل إلى معرفته، فإنّا - والحال هذه - نلجأ إلى المرويات المسندة إلى الأئمّة عليهم السلام ؛ ذلك بأن الأئمّة عليهم السلامهم الأعلم بكتاب اللّه تعالى وما ينطوي عليه من دلالات ومضامين غاية في الروعة .
بيد أنّ الرواية إذا صحّت مضمونا وسندا عن الإمام، يتحتّم على المتلقّي وجوبا الأخذ بها والعمل بالحكم الشرعي الذي يخرجه الإمام من هذه الآية ، وقد يستعمل الإمام منهج تفسير القرآن بالقرآن في روايته، فيكون وصوله إلى الدلالة الشرعية من حيث الدليل أقوى، ومن حيث توافر القناعة أجلى ؛ لأنّ اللّه تعالى هو الأعلم بكتابه، وهو الأعرف بما يُريد، فحينما يُعرِب عمّا يريده من مضمون مبهم في آيةٍ كاشفةٍ أُخرى، يكون اتّباع تلك الآية والعمل بها أمرا مُسلّما به لا حاجة له إلى طول نظر أو تأمّل أو توقّف في موردٍ من موارده .
وتأسيسا على هذا المنطلق أورد الكليني في الكافي موارد تفسيرية أوضح بها قدرة الرواية على حلّ المشكل التكليفي، من خلال تفعيل حيثية عرض الغامض على الواضح، فكان من مصاديق ذلك التوظيف ما أورده من رواية مسندة إلى الإمام الكاظم عليه السلام في مجال القول القاطع بوجود حرمة الخمر في كتاب اللّه تعالى، من خلال كشف المراد الدلالي للفظة «الإثم» في قوله تعالى : «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَ حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالإِْثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»(1)، حيث نجد أنّ لفظة «الإثم» مبهمة في النصّ، فهي اسم جنس مُحلّى ب «ال»، واسم الجنس المعرّف يدلّ على العموم، فتكون هذه
ص: 375
اللفظة دالّة على عموم أصناف الإثم ؛ لأنّها تصدق على كلّ إثم بلا تخصيص أو تحديد .
لهذا أورد الكليني في «باب تحريم الخمر في الكتاب» رواية تنصّ على بيان معنى هذه اللفظة، حيث نقل أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال :
سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر، هل هي محرّمة في كتاب اللّه عزّ وجلّ؟ فإنّ الناس إنّما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها . فقال له أبو الحسن عليه السلام : بل هي محرّمة في كتاب اللّه عزّ وجلّ يا أمير المؤمنين ، فقال له : في أيّ موضعٍ هي محرّمة في كتاب اللّه جلّ اسمه يا أبا الحسن ؟ فقال : قول اللّه عزّ وجلّ : «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَ حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالإِْثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»، فأمّا قوله : «ما ظهر منها» يعني الزنا المعلن، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية ، وأمّا قوله عزّ وجلّ : «وَمَابَطَنَ» يعني ما نكح من الآباء ؛ لأنّ الناس كانوا قبل أن يُبعث النبيّ صلى الله عليه و آله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها، تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أُمّه، فحرّم اللّه عزّ وجلّ ذلك ، وأمّا «الإِثْمَ» فإنّها الخمرة بعينها، وقد قال اللّه عزّ وجلّ وفي موضعٍ آخر : «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ»(1)، فأمّا الإثم في كتاب اللّه فهي الخمرة والميسر، وإثمهما أكبر كما قال اللّه تعالى .
قال : فقال المهدي : يا علي بن يقطين، هذه واللّه فتوى هاشمية، قال : قلت له : صدقت واللّه يا أمير المؤمنين، الحمد للّه الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت .
قال : فواللّه ما صبر المهدي أن قال لي : صدقت يا رافضي(2) .
عند النظر في رواية الإمام الكاظم عليه السلام نجد أنّه قد استعمل منهج تفسير القرآن بالقرآن ، فقد أبان في روايته التفسيرية إبهام حرمة الخمر من خلال حَلّه لإبهام لفظة
ص: 376
«الإثم» في قوله تعالى : «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَ حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالإِثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»، حيث عرض غموض لفظة «الإثم» على وضوح قوله تعالى : «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ»، فعُلِمَ بأنّ الإثم تعني الخمر ، ولهذا أعرب الإمام عن هذا صراحةً بقوله : «وأمّا الإثم فإنّها الخمرة بعينها» . ولمّا كان الإثم محرّما في آية تحريم الفواحش، وعلمنا بأنّ لفظة الإثم تعني «الخمر» في آية السؤال عن الخمر والميسر، دلّ هذا على أنّ الخمر «الإثم» محرّم من آية تحريم الفواحش .
وإذا ما حاولنا تتبّع تصريح الإمام وتفسيره لآية تحريم الفواحش مقاربةً منّا لمعرفة المنطلق التأسيسي الذي اعتمده الإمام في بيان أصناف المحرّمات، فإنّا سنجد أنّ الإمام عليه السلام قد استند إلى منهج تفسير القرآن بالقرآن في كلّ صنفٍ أبانه من هذه المحرّمات، بيد أنّه تارةً يصرّح بالآية المفسّرة، وتارةً أُخرى لا يصرّح بتلك الآية المفسّرة ، ذلك بأنّا إذا نظرنا إلى آية تحريم الفواحش، فسنقف على أنّ جميع المحرّمات في الآية هي مبهمة ، فالفواحش جمعٌ التصق به « ال »، فدلّ على العموم ، والعموم من أدوات الإبهام في الخطاب العربي . وكذا الحال للإثم، فهو اسم جنس اتّصل به « ال »، فدلّ على العموم أيضا .
ولا تختلف لفظة «البغي» في هذا الصدد كثيرا عن لفظة «الإثم»، ذلك بأنّ لفظة «البغي» مصدر متّصل بالألف واللاّم ليدلّ على عموم أنواع البغي أيضا، فهو شبيه بقولك «الضرب لزيد حرام»، فهذه العبارة تعني تحريم كلّ أنواع الضرب وأشكاله على زيد وبالكيفيات جميعها ، ومثاله أيضا قولك : «اعطوا الكرم لمحمّد خاصّة»، حيث تدلّ العبارة على إعطاء كلّ أنواع الكرم لمحمّد ، من مأكل حسن ومشرب عذب ولباس ناعم واحترام عال وشفاعة مؤدّاة وتقديم له في المجالس، وغير ذلك من وجوه التكريم .
من هنا نفهم أنّ أصناف التحريم في الآية كلّها مبهمة، بيد أنّ اللّه تعالى وضع بعض التخصيصات للفظتي «الفواحش» و«البغي»، فأمّا «الفواحش» فحدّدها بأنّ منها
ص: 377
الظاهرة ومنها غير الظاهرة، وكلاهما محرّم ، وأما «البغي» فقد حدّدها بغير الحقّ .
نقول: إنّ الفواحش وإن حدّدها بالظاهرة والباطنة، إلاّ أنّ المعنى فيها ما يزال يشوبه شيءٌ من الغموض ، ولهذا نحسب أنّ الإمام قد استدلّ على تحديد معنى الفواحش الظاهر منها والباطن من خلال عرض هذه الآية على كتاب اللّه تعالى نفسه، فإذا ما تتبّعنا لفظة «الفاحشة» في التعبير القرآني لوجدناها تدلّ على «الزنا»، وهو المعنى الذي فسّر به الإمام عليه السلام لفظة الفواحش ، وهذا الزنا تارةً يشير إليه النصّ القرآني على أنّه زناً مُعلن فيعبّر عنه بالفاحشة ، وتارةً أُخرى يشير إليه على أنّه زناً غير مُعلن مثل زواج الابن من امرأة أبيه، وقد عبّر عنه بالفاحشة أيضا.
بيد أنّ الحاسم ما بين التعبير بذات اللفظ، هو قرائن السياق الذي ترد فيه لفظة «الفاحشة»، فهي التي تحدّد كون المراد الزنا المعلن أم الزنا المبطن «زواج الابن من امرأة أبيه»، ومصداق ذلك قوله تعالى : «وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُو كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلاً»(1)، فلفظة «الفاحشة» في هذه الآية - مثلاً - تدلّ على الزواج بزوجة الأب المتوفّى، والمعنى واضح من قرائن السياق بلا عناء ، على حين أنّ قوله تعالى : «وَ لاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُو كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً»(2)، نجد فيه لفظة «الفاحشة» تدلّ على الزنا المعلن صراحةً، ولا إشارة للدلالة على معنى الزواج بزوجة الأب المتوفّى . ومن ذلك أيضا قوله تعالى : «وَالَّتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً»(3)، فالنصّ واضح في دلالته على الزنا المعلن .
من هنا نقرّر أنّ لفظة «الفاحشة» في الأعمّ الأغلب تدلّ في السياقات القرآنية على معنيين، هما: «الزنا المُعلن» وهو ما عبّر عنه اللّه تعالى بالفاحشة الظاهرة ، و«زواج
ص: 378
الابن بزوجة الأب المتوفّى»، وهو ما سماه سبحانه بالفاحشة المُبطّنة ؛ ذلك بأنّ زواج الابن بزوجة الأب أمر خارج عن نطاق الشريعة، ومن ثمّة يكون الأداء الزوجي في هذه الحال ناءٍ عن أصل التشريع وحلّية المباشرة .
أمّا لفظة «البغي»، فقد خصّصها سبحانه بقوله : «بِغَيْرِ الْحَقِّ»؛ لكي لا تختلط مع البغي بحقّ ، وثمّة مصداق لداعي هذا التخصيص والإيضاح من النصّ القرآني، وهو قوله تعالى : «وَلاَ تَعْثَوْاْ فِى الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ»(1)، فقد قيّد سبحانه العثو بقوله «مفسدين»؛ لأنّ من العثو ما لا يؤدّي إلى الإفساد، وهو ردّ الظلم على الظالم، فهو في ظاهره يمثّل العثو في الأرض، بيد أنّ نيّة العمل هي الاصطلاح وردّ الظلم على أهله(2) .
لذا كان التحديد بقوله تعالى: «بغير حقّ» واجب وله مصداق توضيحي في النصّ القرآني ، أمّا لفظة «البغي» فقد صَمَتَ عن بيانها الإمام؛ لأنّ البغي يدلّ على معنى الظلم . والمتتبّع للسياقات القرآنية سيجد أنّ لفظة «البغي» في النصّ القرآني تدلّ على
معنى الظلم عموما بلا استثناء(3) ، والظاهر أنّه لا حاجة للإمام إلى أن يُوضّح هذه المفردة؛ ذلك بأنّ الظلم محرّم بأنواعه كافّة، يقول سبحانه : «ذَ لِكَ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِى ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»(4)، وفي موضعٍ آخر قال سبحانه : «إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَ اهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِ الصِّرَ طِ»(5) ، ولوضوح الأمر اكتفى الإمام ببيان لفظتي الفواحش والإثم فحسب .
ص: 379
من هنا نقرّر أنّ الإمام عليه السلام قد اتّبع منهج تفسير النصّ للنصّ، فتارةً يصرّح بذلك، وأُخرى يحيل الأمر على المتلقّي ليُدرك ذلك ، أمّا بيانه عليه السلام لحرمة الخمر وكشفه عن إبهام لفظة «الإثم»، فإنّ تفسيره هذا وإقراره لحرمة الخمر يعدّ براعة عالية وقدرة لا مثيل لها في التقاط بيان الآية من آيةٍ أُخرى.
ولو تأمّلنا الآية التي استند إليها الإمام في بيان دلالة لفظة «الإثم» - وهي آية السؤال عن الخمر - فسنجد أنّ الآية التي أحال عليها الإمام مكتنزة بجملة من القرائن الخطابية التي تثبت حرمة الخمر فعلاً زيادةً على إثبات الحرمة في آية تحريم الفواحش ، فإذا ما أوردنا النصّ على جادة منهج التحليل النصّي، فإنّا سنقف فيه على الآتي :
1 - إنّ السؤال عن الخمر والميسر ابتداءً في قوله تعالى : «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ»، يدلّ دلالة لا تقبل الشكّ والتردّد على أنّ أمر الخمر والميسر بات يشكّل قلقاً كبيرا وتساؤلاً متواصلاً في أذهان المسلمين، فالسؤال عنهما يمثّل قرينة استشعارية عن مدى تحسّسهم لضرر الخمر والميسر على مجتمعهم على حدٍّ سواء ، وهذا الاستشعار ينذر بوجود ضرر بالغ فيهما، والضرر في ماهية الشيء يدخل نطاق التحريم، ما زال ملازما لماهيته .
2 - صاغ سبحانه نصّ الإجابة عن هذا التساؤل على بنية الجملة الاسمية دون البنية الفعلية ؛ ليثبت دلالة الإثم في الخمر والميسر ، ذلك بأنّ لزوم المعنى وديمومته إنّما تتأتّى من بناء مضمون العبارة على الجملة الاسمية، فلمّا أراد سبحانه لزوم دلالة الإثم للخمر ودوام استمرارها في ذهنية المتلقّي ، أورد الخطاب على هذه الصيغة دون غيرها .
3 - إنّ الناظر في النصّ بتأنٍّ يقف على نمطٍ من العدول التركيبي في بنية الجملة الاسمية ؛ إذ تقدّم الخبر «فيهما» على المبتدأ «إثم كبير»، ونحسب أنّ علّة ذلك أمران:
أوّلهما : إنّ التقديم يشعر بالأهمّية والعناية بالمقدّم، ولمّا كان الخمر والميسر
ص: 380
هما مدار الحديث، وجب تقديمهما؛ ليفهم المتلقّي أنّ الكلام يدور عليهما، وأنّ ما بعدهما بيان لهما، وهو قوله : «إثم كبير»، فلو جرى الخطاب على الأصل الأمثل للمنظور النحوي فقدّم سبحانه المبتدأ على الخبر فقال: «قل إثم كبير فيهما» ؛ لما أعطت هذه التركيبة الخطابية الاهتمام الكافي لبيان حرمة الخمر ، فقد جرى محور الكلام ها هنا على الإثم، ولم ينصبّ كلّيا على الخمر والميسر اللذين هما أساس الكلام وجوهره .
من هنا يتقرّر أنّ تقديم الجار والمجرور «فيهما» ابتداءً، يضفي قوّة وهيبة على الأمر المُتحدّث عنه أصالةً، ويمنح النصّ التفاتا أكبر وشدّا أعلى لما بعد الجار والمجرور، فقولك : «إثمٌ كبيرٌ فيهما» أقلّ تأثيرا من بيان دلالة الإثم في الخمر والميسر من قولك : «فيهما إثمٌ كبيرٌ» ؛ ذلك بأنّ العبارة الأخيرة تدعو المتلقّي إلى الانتظار قليلاً قبل بلوغه معرفة ما فيهما ، والانتظار يدعو إلى اللهفة وانبعاث الرغبة في معرفة المراد .
فضلاً عن أنّه سبحانه قد اختار حرف المعنى «فيهما» بدقّة عالية ؛ لأنّ دلالة «في» هي الظرفية الداخلية، كقولك : «زيد في الدار»، فهذا يعني أنّ زيداً داخل الدار ، بهذا نجد أنّ صفة ثبوت الإثم في الخمر لم تتأتّ عن طريق بناء الجملة على الاسمية فحسب ؛ بل إنّ لتوظيف حرف المعنى «في» في الجملة دون غيره أثرا في إشباع صفة الثبوت للخمر ؛ ذلك بأنّ الجار والمجرور «فيهما» يدلاّن على أنّ الإثم داخل في الخمر ملازم لها، لا ينفكّ عنها في كلّ أحوالها ، ولمّا كان الإثم كامنا فيها، وجب بهذا حرمتها ، ف «الآية دالّة على أنّ الخمر مشتملة قطعا على الإثم ، والإثم حرام»(1) ؛ لأنّ ملازمة الإثم للشيء يدعو بالضرورة إلى حرمة ذلك الشيء، نأيا عن الوقوع في دائرة الإثم الأكبر ؛ «إذ لا إثم في غير مُحرّم»(2) البتّة .
ص: 381
وقد أكّد الرازي ملازمة الإثم للخمرة في إجابته على من قال: «الآية لا تدلّ على أنّ شرب الخمر إثم ، بل تدلّ على أنّ فيه إثما ، فهَب أنّ ذلك الإثم حرام، فلِمَ قلتم : إنّ شرب الخمر لمّا حصل فيه ذلك الإثم وجب أن يكون حراما»(1) ، فأجاب الرازي مؤسّسا إجابته على قاعدة ملازمة الإثم للخمر بقوله : «لأنّ السؤال كان واقعا عن مُطلق الخمر ، فلمّا بيّن تعالى أنّ فيه إثماً ، كان المراد أنّ ذلك الإثم لازم له على جميع التقديرات ، فكان شرب الخمر مُستلزما لهذه الملازمة المحرّمة ، ومستلزم المحرّم محرّم ، فوجب أن يكون الشرب محرّما»(2) .
4 - وظّف سبحانه لفظة «كبير» لبيان دلالة التحريم في الآية ، إذ وردت لفظة «إثم» مطلقة؛ لأنّها نكرة في سياق إثبات، فقيّدها سبحانه بالنعت «كبير» ؛ ليوضّح بهذا النعت مراد النصّ من أنّ صفة الإثم في الخمر ليست صفة مبهمة حتّى يخال القارئ أو المتلقّي بأنّ هذا الإثم قد يكون صغيرا ، ذلك بأنّ من دواعي التنكير تصغير الأشياء وتحقيرها ، فمن أجل أن لا يخطر هذا التوقّع الدلالي على النصّ، حسم سبحانه المضمون بالصفة «كبير» للدلالة على حرمة الخمر ؛ لأنّ إثمهما ليس بإثمٍ صغيرٍ يمكن أن يُغفر أو يُتغاضى عنه ، بل هو كبير، وهذا الكبر يستلزم الابتعاد عنه، وكلّ ما كان إثمه كبيرا فهو محرّم بالضرورة .
ويبدو أنّ الطوسي قد استوثقت لديه القناعة في أنّ هذا النصّ يحتوي على دلالة تحريم الخمر، بناءً على إتباع لفظة «إثم» بالصفة «كبير»، إذ قال : «إنّه - يعني اللّه - قد وصفها بأنّ فيها إثما كبيرا ، والكبير محرّم بلا خلاف»(3)، فلا أضرّ من الكبير .
ولا داع من القول بأنّ الإثم الكبير هو مباح من حيث الممارسة والأداء، وإلاّ لِمَ وصفه اللّه تعالى بأنّه كبير ، ولهذا «لمّا نزلت هذه الآية، أحسّ القوم بتحريمها وعلموا
ص: 382
أنّ الإثم ممّا ينبغي اجتنابه»(1) ، فما بالُك إذا كان كبيرا .
وتأسيسا على وجود صفة «كبير» في النصّ ، رأى الطباطبائي أنّ الخمر مصداق صريح للإثم، وأنّ اللّه تعالى قد وصف القتل وكتمان الشهادة والافتراء بالإثم فحسب، ولم يقيّده بالكبر، على الرغم من أنّ سائر ما وصفه سبحانه بالإثم هو مُحرّم. من هنا نستدلّ على أنّ الخمر محرّم أيضا ، بل إنّ حرمته واضحة واجبة؛ لوجود القيد الوصفي «كبير» للإثم(2) .
وتأسيسا على هذا الاستقراء من الطباطبائي، توصّل في نهاية عرضه لتفسير هذه الآية إلى دلالة القطع الحازمة بتحريم الخمر في هذا النصّ، وذلك في مقولته: «وبالجملة ، لا شكّ في دلالة هذه الآية على التحريم»(3). فنلحظ أنّ الطباطبائي قد نفى جنس الشكّ عموما من القول بعدم تحريم الخمر في هذه الآية ، وهذا يوحي بعمق إيمانه القطعي بأنّ الخمر قد حُرّم تأسيسا على هذا النصّ .
ولا يأخذنا الشكّ البتّة في أنّ الطباطبائي قد اطّلع على مرويات الإمام الكاظم عليه السلام في هذا المجال، ولهذا قطع بدلالة الحرمة في هذا النصّ ابتداءً .
5 - إنّ استعماله سبحانه لصيغة التفضيل «أكبر من» في قوله : «وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا»، يدلّ دلالة جلية على حرمة الخمر إذا ما أُسندت هذه الدلالة إلى نطاق الترجيح العقلي ؛ ذلك بأنّ القاعدة العقلية تقول : إنّ ما كان ضرره أكبر من نفعه، فإنّ تركه أولى من العمل به ، فحينما قال: «وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا»، صرّح برجحان الإثم والعقاب، وذلك يوجب التحريم(4) ف «إذا زادت مضرّة الشيء عن منفعته، اقتضى العقل الامتناع عنه»(5) .
ص: 383
فاسم التفضيل في الآية كَشفَ المراد وأبان أنّ الإثم «المنهيّ عنه» أكبر من المنفعة «المباحة»، ونلحظ أنّ الموازنة بين الإثم والمنفعة قد صيغت على الإفراد في كلا طرفي التفضيل، فلم يقل «وإثمهما أكبر من منافعهما» ؛ وعلّة ذلك - فيما أحسب - أنّ المنافع على كثرتها في الخمر لا تعدّ شيئا إزاء الإثم فيها ، لهذا أفرد سبحانه المنافع ليوضّح بأنّ منافع الخمر على تكاثرها هي لا تساوي شيئاً قياسا لعواقبها، من هنا فهي تُعامل معاملة المنفعة الواحدة (المنفردة) ، لذا «لا تغترّوا بالنفع فيها، فالضرر أكبر منه»(1) .
فأفرد سبحانه «المنافع» ليظهر ضآلة هذه المنفعة وقلّتها مهما تعدّدت، قياسا إلى كبر الذنب الذي يحتمله المرء من شربها أو التعامل بها.
هذا من وجهة نظر دلالية ، أمّا من وجهة نظر لغوية، فإنّ صياغة الخطاب لغويا تُحتّم إفراد المنفعة دون جمعها ؛ ذلك بأنّه «لمّا قوبل ثانياً بين الإثم والمنافع بأكبر، أوجب إفراد المنافع وإلغاء جهة الكثرة فيها، فإنّ العدد لا تأثير له في الكبر ، فقيل :
«وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» ، ولم يقل : من منافعهما»(2) ؛ لأنّ جهة المفاضلة في هذه العبارة قد أُحيلت من حيز الكثرة العددية إلى حيز الكبر الحجمي ؛ ليبيّن سبحانه بأنّ هذه «المنافع» على كثرتها وجمعها هي أصغر في قياس الحجوم من الإثم الكبير فيها .
ويبدو أنّ إحداث هذه النقلة في اسم التفضيل وعدم التعبير بقوله «أكثر من»، له ارتباط وثيق بالملازمة الدلالية التي تحملها لفظة «أكبر من» ومشتقّاتها، سواء كان ذلك على مستوى التعبير القرآني المعجز، أم التعبير البشري المعتاد؛ إذ غالباً ما ترد هذه اللفظة للدلالة على الذنب والإثم، فكأنّ دلالتها على هذا المعنى أمر ملازم لها، ف «الكبر مثل العظم، ومقابله الصغر ، والكبير : العظيم ، قال تعالى : «وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ
ص: 384
مُّسْتَطَرٌ»(1) ، وقد استعملوا في الذنب إذا كان موبقا الكبيرة ، كقوله: «كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ»(2)، و«كَبَآئِرَ الاْءِثْمِ»(3) . وقالوا في غير الموبق صغير وصغيرة ، ولم يقولوا قليل ، ومقابل القليل الكثير، كما أنّ مقابل الكبير الصغير»(4) .
لهذا كان من الواجب أن يرد اسم التفضيل على قوله «أكبر من» ؛ لأنّ الكبر مرتبط بالتعبير عن الإثم ، لذا وافق مجيء اسم التفضيل «أكبر من» بعد لفظة «الإثم»، فحقّ بهذا إفراد المنافع؛ لأنّها عوملت معاملة المفاضلة بين الذنوب والآثام ، فرجَحَ ترك الخمر على التعامل بها، فخرجت «المنافع» من مقايسة التعدّدية إلى مقايسة الحجوم ، إذ ينظر إليها على أنّها ذنب وإثم ؛ لأنّ منافع الخمر في حقيقتها آثام وليست أرباح، كما يحسب المتعاملون بها ، لهذا استعمل سبحانه المفاضلة ب «أكبر من» بين إثم التعامل بالخمر وإثم النفع بها ، والأظهر لدينا أنّ كليهما إثمٌ، لذا سيقا على المفاضلة ؛ لأنّ المفاضلة تعني عملية الترجيح في صفة مشتركة بين طرفين قد غلبت في أحدهما على الآخر .
وبهذا نستحصل أنّ الخمر لمّا كانت إثما «شربا ونفعا»، وجب حرمته بالضرورة اللاّزمة .
من هنا نجد أنّ جميع المسالك الدلالية للآية وحيثيات بناء الخطاب فيها تؤيّد حرمة الخمر استدلالاً، وهذا يسند يقينية الدلالة التي توصّل إليها الإمام الكاظم عليه السلام من خلال عرضه لغموض لفظة «الإثم» في آية تحريم الفواحش، على هذا النصّ الذي وقع الإثبات فيه على تحريم الخمر ؛ لأنّها الإثم بعينه كما نصّ الإمام في روايته .
ص: 385
لقد أورد الكليني رواية عن الإمام الصادق أوضح فيها دلالة التيمّم من حيث الموضع الذي يجب فيه التيمّم من الجسد ، حيث يقول سبحانه: «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُو عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»(1) ، فنجد أنّ قوله تعالى: «فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ» مبهم من حيث عدم تحديد موضع مسح اليد ؛ ذلك بأنّ مسح الوجه واضح الدلالة، فالوجه ما ابتدأ بمنابت الشعر وانتهى إلى أسفل الذقن ، أمّا اليد فهي مبهمة من حيث التحديد، فلا يمكن الاهتداء إلى دلالتها الحدّية أو التحديدية بيسرٍ وسهولة .
لهذا بيّنها الإمام الصادق عليه السلام فيما أورده الكليني عنه من روايات في هذا الصدد ؛ حيث روي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سُئل عن التيمّم فتلا هذه الآية : «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»(2)، وقال : «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»(3) ، قال : «فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع»(4)، فنلحظ أنّ الإمام الصادق عليه السلام قد فسّر وحدّد موضع التيمّم من خلال المقارنة بين آيتي السرقة والوضوء ، حيث أورد سبحانه في آية الوضوء قيدا تحديديا ل «اليد»، وذلك بقوله «إلى المرافق» ، على حين أطلق لفظة «اليد» ولم يحدّدها في قوله: «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا» .
بيد أنّ السنّة قيّدت وحدّدت موضع القطع في حكم السارق، وهو ما بنى عليه
ص: 386
الإمام الصادق عليه السلام حكمه في تحديد موضع المسح، وهو موضع القطع للسارق ، وموضع القطع يكون - تأسيسا على مرويات السنّة - من أُصول الأصابع ، فعند النظر إلى قوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَم بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»(1)، نجد أنّ اللّه تعالى قد حكم على السارق أو السارقة بقطع اليد، بيد أنّ مقدار هذا القطع داخل في حيز الإبهام والغموض، فمن أيّ موضع يمكن أن تُقطع يد السارق؟ ويبدو أنّ هذا الأمر كان يمثّل مناط إشكال عن العلماء ، ولهذا سُئل عنه الإمام الصادق عليه السلام في غير موضع، فيما نقل عنه الكليني فأجاب ، حيث روى الكليني في «باب حدّ القطع وكيف هو» عن «علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : مِن أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ها هنا، يعني من مفصل الكفّ»(2) .
وأورد الكليني رواية أُخرى هي أكثر وضوحا وأجلى دلالةً من الرواية الأولى، يقول فيها :
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : القطع من وسط الكفّ، ولا يُقطع الإبهام، وإذا قُطعت الرجل تُرك العقب لم يُقطع(3) .
فنلحظ أنّ قطع اليد قد حدّده الإمام من أُصول الأصابع الأربعة دون الإبهام، حيث يقول عليه السلام :
تُقطع يد السارق ويُترك إبهامه وصدر راحته(4) .
ص: 387
وعلّل الإمام هذا المنحى التحديدي بقوله: «تُقطع الأربع أصابع وتُترك الإبهام ؛ يَعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة»(1)، فمن أجل أن يؤدّي السارق صلاته صحيحة بالسجود على راحته وإبهامه وهو موضع السجود الصحيح والكامل لليد، يُترك إبهامه وتُقطع الأصابع الأربعة من أُصولها فحسب .
والأظهر لدينا أنّ الإمام الصادق عليه السلام قد اعتمد في هذا الموضع في بيان دلالة تحديد موضع القطع على قوله تعالى: «وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا»(2)، إذ نُقل عن الإمام الجواد عليه السلام أنّه وظّف آية قرآنية في بيان تحديد موضع قطع يد السارق ، ومن الغريب واللاّفت للنظر أنّ الكليني لم يورد هذه الرواية وهو في معرض حديثه عن موضع حدّ السرقة، فقد اكتفى بذكر موضع القطع بالروايات المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام فحسب ، ولم يذكر علّة بيان ذلك الحكم التحديدي من التعبير القرآني. أو بتعبيرٍ آخر لم يذكر على أيّ شيء استند الإمام الصادق في ذلك التحديد ؛ لذا نرى من الأجدى أن نبيّن تلك العلّة وذلك السبب الكامن وراء هذا التحديد ، حيث نُقل عن أبي داوود تأويل الإمام الجواد عليه السلام قوله تعالى: «وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا»(3)
على غير معناه الظاهر، وأنّه وظّف الدلالة التأويلية لهذا النصّ لاستنباط حكم شرعي غاية في الأهمّية ؛ إذ تنقل لنا مدوّنات التفسير أنّ الإمام الجواد عليه السلام قد ضمّه والمعتصمَ العبّاسي مجلسٌ واحدٌ، فتناقش الفقهاء والعلماء في المجلس لتحديد مقدار القطع من يد السارق بعد ثبوت السرقة عليه، فأدلى كلٌّ بدلوه ، إذ يروي أبو داوود:
إنّ سارقا أقرّ على نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة ]المعتصم] تطهيره بإقامة الحدّ عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمّد بن علي [الجواد] عليه السلام ، فسألنا عن القطع في أيّ موضعٍ يجب أن يُقطع ؟ قال : فقلت من الكرسوع ، قال : وما
ص: 388
الحجّة في ذلك ؟ قال : قلت : لأنّ اليد هي الأصابع والكفّ إلى الكرسوع ، لقول اللّه في التيمّم : «فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ»(1)، واتّفق معي على ذلك قوم . وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك ؟ قالوا : لأنّ اللّه لمّا قال : «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»(2) في الغسل، دلّ ذلك على أنّ حدّ اليد هو المرفق . قال : فالتفت إلى محمّد بن علي عليه السلام فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟
فقال : قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني ممّا تكلّموا به، أيّ شيء عندك ؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمتُ عليك باللّه لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال : أمّا إذا أقسمت عليَّ باللّه إنّي أقول إنّهم أخطؤوا فيه السنّة، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع فيُترك الكفّ، قال : وما الحجّة في ذلك ؟ قال : قول رسول اللّه عليه وآله وسلّم "السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين" ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال اللّه تبارك وتعالى : «وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ»، يعنى به هذه الأعضاء السبعة التى يسجد عليها، «فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا»، وما كان للّه لم يُقطع.
قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ(3) .
فنلحظ من هذه الرواية أنّ الإمام الجواد عليه السلام قد تأوّل النصّ القرآني: «وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» على غير معناه الظاهر، فأرجعه إلى معنىً آخر مُنتزعا منه تشريعا حكميا أثبت به حدود القطع من يد السارق، وذلك من خلال توظيف النصّ القرآني نصّاً مفسّرا لإبهام ما ورد من شأن موضع القطع في آية السرقة .
والأظهر لدينا أنّ هذه الدلالة التأويلية التي وصل إليها الإمام، هي دلالة ترقى إلى مستوى التفسير الواضح للنصّ ؛ لأنّه لا يمكننا بأيّ حالٍ من الأحوال أن نقول إنّ ثمّة دلالة تأويلية أُخرى ترجح على دلالة الإمام في النصّ. بهذا يعدّ تأويل الإمام تفسيرا
ص: 389
واضحا للنصّ، لا تأويلاً ترجيحيا كحال سواه .
وبهذا يمكن القول: إنّ الإمام الصادق في حكمه على تحديد موضع التيمّم بناءً على آية السرقة، كان مدركا ابتداءً موضع القطع ليد السارق، ولهذا أسّس عليه الحكم بإيراده آية السرقة تفسيرا ضمنيا لبيان موضع التيمّم في آية التيمّم الأُخرى، فاستعمل - والحال هذه - منهج تفسير القرآن بالقرآن في هذا الموضع، فكشف عن الدلالة وأزاح الإبهام بمهارة عالية .
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى مسألة مهمّة في نطاق الحديث عن التأويل الذي توظّفه السنّة لبيان بعض ما أُبهم في النصّ القرآني، ألا وهي: «إنّ التأويل إذا كان صادرا عن المعصوم، فيعود التأويل تفسيرا ؛ لأنّه يكشف عن مراد اللّه تعالى ، وتكون دلالته في هذا الملحظ بالذات دلالة قطعية»(1)، إذ يخرج عن نطاق ظنّية الدلالة الملازمة لعملية التأويل ، وبهذا المنظور يعدّ تفسيرا ؛ لأنّه يوقف المتلقّي على معنىً مراد قد صدر من
المعصوم عليه السلام .
أمّا إذا تأوّل أحد المفسّرين معنىً ما لنصٍّ قرآني، فإنّ الدلالة التأويلية التي يصل إليها ذلك المُفسّر - مهما بلغت قوّة دليله فيها - تبقى في حيز النطاق التأويلي، ولا تخرج إلى نطاق التفسير أبدا ؛ لأنّ سمة الظنّية تبقى مرادفة لهذه الدلالة التأويلية .
وفي موضعٍ آخر من الكافي نجد أنّ الكليني قد وظّف رواية تفسيرية للإمام الصادق عليه السلام ذكر فيها بيان معنى «الأبصار»، في قوله تعالى: «لاَّ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»(2)، إذ القارئ لهذه الآية يخطر في باله تبادرا أنّ دلالة «الأبصار» فيها منصبّة على معنى البصر (الحاسّة المعروفة)، فيكون المعنى أنّ اللّه
ص: 390
تعالى لا يمكن لأيّ عينٍ أن تبصره وتراه؛ لأنّه لا يُحدّ ولايُشخّص عيانا من أيّ إنسانٍ مهما بلغت درجته، ومهما علا شأنه عنده سبحانه، على حين أنّ قراءتنا إلى ما أورده الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام - في نطاق منهج تفسير القرآن بالقرآن - تقودنا إلى أنّ هذه الدلالة التبادرية ليست هي الدلالة المطلوبة البتّة ، بل إنّ الأمر أبعد من ذلك، وإنّ
الدلالة المرادة أقصى من أن نتصوّرها، حيث نقل الكليني:
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله : «لاَّ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ»، قال : إحاطة الوهم، ألاَ ترى إلى قوله : «قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ»(1)، ليس يعني بصر العيون «فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِى»(2)، ليس يعني من البصر بعينه «وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا»(3)، ليس يعني عمى العيون، إنّما عنى إحاطة الوهم، كما يقال : فلان بصير بالشِعر ، وفلان بصير بالفقه ، وفلان بصير بالدراهم ، وفلان بصير بالثياب ، اللّه أعظم من أن يُرى بالعين(4) .
فالإمام عليه السلام كشف في هذه النصّ الروائي أنّ المراد بدلالة الأبصار ليس البصر العيني الحسّي ، بل المبتغى هو البصر الذهني، وهذا جلي من استدلاله بالنصوص الثلاثة من آية الأنعام، فجميع ما أورده الإمام من استشهاد، يدلّ على أنّ المراد من لفظة «الأبصار» هو البصر الذهني، فالبصيرة كما يرى المفسّرون «نور القلب الذي به يستبصر، كما أنّ البصر نور العين الذي به تبصر»(5) .
من هنا تكون «البصائر جمع بصيرة، وهي للنفس كالبصر للبدن، سُمّيت بها لدلالة؛ لأنّها تجلّى لها الحقّ وتبصرها به»(6) . ولهذا دلّ الإمام عليها بقوله: «إحاطة الوهم»؛
ص: 391
لأنّ البصيرة تكون في القلب، والمقصود بالقلب في خطاب المفسّرين هو «العقل»، ذلك بأنّ القلب لا يتصوّر الأشياء، وإنّما الذي يدركها ويتصوّرها العقل «الذهن البشري».
ولمّا كان العقل هو موضع التفكير والتصوّر والتوهّم والخيال، عبّر عنه سبحانه بالأبصار؛ لأنّه يُبصَر به من خلال التصوّر . وعلى الرغم من أنّ التصوّر العقلي لا حدود له ولا حدّ ، فإنّه لا يمكنه بأيّ حالٍ من الأحوال أن يحيط باللّه تعالى مهما بلغ واجتهد في تصوّره وتوهّمه، ومهما كانت درجة ذلك التصوّر ومقدرة ذلك العقل المُصّور ، فكأنّ الإمام بتفسيره ل «الأبصار» بآية الأنعام - التي أثبت بها أنّ الأبصار هي الأوهام - قد رجع خطوة إلى الوراء في نطاق بيان دلالة آية: «لاَّ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ» ؛ إذ ليس المراد إبصار العيون، وإنّما إبصار العقول .
فكأنّ الإمام بهذا التفسير القرآني قد بيّن مكانة اللّه تعالى وعظمته وعلوّ شأنه عن الإدراك بأيّ صورة من الصور، فهو لم يفسّر النصّ بأبصار العيون كما يخاله الناس جميعا ، بل فسّرها بأبصار العقول ؛ ذلك بأنّ الذي لا يستطيع أن يرى اللّه سبحانه بعينه، فلربّما يخطر في باله أنّه قادر على أن يراه في تصوّره وعقله «تشخيصا»، أو قد يحسب بعض الناس أنّ اللّه تعالى نفى إبصاره بالعيون ولم ينفِ إبصاره بالعقول، ومن ثمّة فإنّ مسألة تصوّره والنظر إليه في الخيال الذهني أمر ممكن، وقد تكون إحدى تلك التصوّرات معبّرة عنه فعلاً، كما هو في الحقيقة الوجودية له .
فمن أجل أن لا يحدث هذا الاضطراب الدلالي أو الاستدلالي بأسره، عاد الإمام خطوة إلى الوراء في تفسيره للفظة «الأبصار»، وأسندها بدلالة آية أُخرى فأقرّ المتلقّي على أنّ معناها هو «الإبصار الذهني» ؛ ذلك بأنّ نفي الإبصار الذهني أبلغ في إبعاد مراد رؤيته تعالى من نفي الإبصار العَيني؛ لأنّ العين ترى أشياء ومجسّمات مشخّصة وظاهرية فحسب، فهي محدودة ومحكومة بالموجود الخارجي، على حين أنّ البصيرة «العقل أو التصوّر الذهني» بمقدرته أن يتصوّر أشياءً أكثر من التي تراها العين
ص: 392
«الباصرة»، ومن ثمّة يكون التصوّر على اللّه تعالى جارٍ عقلاً إذا ما حملنا لفظة «الأبصار» على العين الباصرة دون البصيرة العقلية الباطنة ، ولهذا قال الإمام في ذات الموضع: «إنّ أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون، فهو لا تدركه الأوهام وهو يدرك الأوهام»(1) .
ومن الجميل في الأمر أنّ لفظة «الأبصار» قد سيقت في النصّ الذي فسّره الإمام على هيأة الجمع المُحلّى ب «ال»، فضلاً عن أنّها واقعة في سياق نفي. ومن السائد في المنظور اللغوي والأُصولي أنّ الجمع المعرّف يفيد دلالة العموم، وأنّ اللفظة إذا سيقت بعد نفي دلّت على العموم أيضا ، فيمكن القول تأسيسا على هذا: إنّ لفظة «الأبصار» في الآية تضمّ جميع أنواع الأبصار «البصري والذهني»، بيد أنّ الإمام لمّا فسّرها بالبصر الذهني فقد اكتفى بهذا واستغنى عن القول بالبصر العيني ؛ لأنّ هذا الأخير أبلغ وأجلى لأداء الغرض من الأوّل، فالإبصار الذهني يرد بعد الإبصار العيني بالضرورة، فما عجزت العين عن إدراكه أدركه العقل بالتصوّر، فإذا انتفى التصوّر انتفى البصر العيني تباعا وضرورةً .
لهذا أثبت الإمام دلالة الإبصار الذهني دون العيني، فكانت هذه اللفتة من قبل الإمام - أي القول بدلالة الإبصار الذهني دون العيني - لها أثرها المضموني والتصوّري «الاختزالي» لدى المتلقّي بحيثية أثرى وأبلغ ممّا لو ذكر المعنيين معاً .
على حين - بالمقابل - نجد في تتمّة الآية أنّ اللّه تعالى قادر بمهارة عالية على أن يدرك الأبصار جميعاً، ويقصد بالأبصار ها هنا «التصوّر الذهني» أيضا، ذلك بأنّ إدراك أوهام الناس وتصوّراتهم أمر خفيّ مستبطن لا يمكن أن يُعرف البتّة، بيد أنّ اللّه تعالى قادر على معرفته ، وهذا دليل قاطع على خالقيته للوجود ؛ إذ لا يعرف الخلق إلاّ خالقه .
ولمّا كانت عملية إدراك العقل للّه سبحانه «تصوّرا تشخيصيّا» أمرا مستحيلاً ،
ص: 393
وكان إدراك ما في نفوس الناس وما تختلج به تصوّراتهم العقلية أمرا عسيرا ومستصعبا، عبّر سبحانه عن الحالين بلفظة «الإدراك» ؛ لأنّ الإدراك يعني اللحاق، وهو لا يستعمل إلاّ لمعنى الفوت والضياع، فنلحظ أنّ فيه دلالة التلهّف والإسراع ، فيكون استعمال هذه المفردة ملائماً تامّاً للدلالة العامّة للآية .
فالمعنى لا يلحقنّ أحد البتّة برؤيته سبحانه مهما تلهّف وأسرع ؛ لأنّ الأمر فائت على الجميع ، وكذا الحال لقوله «وهو يدرك الأبصار»، فالمعنى أنّ هذا اللحوق بالأبصار أمر صعب فائت على الجميع، فهو من المستحيل بمكانٍ ما، يدعو إلى أن يعبّر عنه تعالى بلفظة «الإدراك»، ولكن على الرغم من استحالة هذا الأمر وفقدان القدرة لدى الجميع على بلوغه والوصول إليه، فإنّ اللّه تعالى قادر عليه، بل هو الذي يدرك الأبصار جميعاً في كلّ زمان وفي أيّ مكان كانت، وهذا يدلّ على مدى استطالته وسيطرته سبحانه على مخلوقاته .
هذا من جهة، أمّا من جهةٍ أُخرى فيدلّ هذا الانتقاء اللفظي على الروعة القرآنية والإعجاز الخطابي في عملية استعمال المفردة المناسبة للمقام المناسب، إلى الحدّ الذي يمكن معه اختزال دلالات عدّة في لفظة واحدة، فضلاً عن أنّ جميع المفردات التي تركّب منها السياق تدلّ دلالة مترابطة ومتماسكة على المعنى العامّ أو المضمون المركزي الذي يريد المتكلّم إيصاله للمتلقّي، وهذا يدعو إلى الإيمان القاطع بتفسير الإمام للفظة «الأبصار» بالبصر العقلي، فهو حقّاً لا تدركه الأبصار ولا تبلغ كنه خطابه كبار العقول وروائع التصوّرات والأوهام .
لقد نقل الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام - فيما نقله عنه من موارد التفسير القرآني - إيضاحه للفظة «المصلّين» في قوله تعالى: «مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ * قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ»(1)، حيث أورد: «عن إدريس بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته
ص: 394
عن تفسير هذه الآية: «مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ * قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ» ؟ قال : عُني بها لم نك من أتباع الأئمّة الذين قال اللّه تبارك وتعالى فيهم : «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ»(1)، أما ترى الناس يسّمون الذي يلي السابق في الحلبة (مصلّي) ، فذلك الذي عُني حيث قال : «لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ» ؛ لم نك من أتباع السابقين»(2) .
فنلحظ أنّ إدريس قد استشكلت عليه لفظة «المصلّين» في النصّ الكريم ، لذا سأل الإمام عنها ، فأجاب الإمام بأنّ هذه اللفظة تحمل دلالة التبع والولاء لأهل البيت عليهم السلام، فليس المراد من المصلّين أنّهم لم يكونوا يؤدّون فريضة الصلاة كما يحسب المتلقّي ، بل إنّ المراد من هذه اللفظة معنى الولاء لأئمّة الحقّ الذين فرض اللّه ورسوله اتّباعهم ؛ لأنّ منهجهم هو منهج الكتاب المعجز الذي أنزله اللّه على الناس، فاتّباعهم هو اتّباع للقرآن، فهم صنو الحقّ ومَوئله ، فإذا ما تخلّفوا عنهم سقطوا .
واستدلّ الإمام على هذا المعنى من قوله تعالى: «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ»، فالسابق لا بدّ له من لاحق، وكلّ لاحق هو تبع وتابع بالضرورة، ولمّا كان المقصود من لفظة «السابقون» في الآية هم الأئمّة عليهم السلام، كانت لفظة «المصلّين» من هنا تدلّ على معنى التبع لأُولئك السابقين ، فكأنّ الإمام حمل لفظة «المصلّين» في الآية على المَعطى المعجمي(3) لها دون الدلالة الشرعية المتداولة عند المسلمين، وهي الصلاة بمعنى الفريضة ؛ ذلك بأنّ الذي سلكهم في سقر هو شيء أكبر من تركهم للصلاة، أو بتعبيرٍ آخر هو شيء أكبر من اتّباعهم للصلاة وأدائها دون أن يكونوا من أتباع الحق ؛ لأنّ الصلاة تُلزم مؤدّيها أن يسلك سبيل الحقّ ويتّبع الهُداة إليه .
فإذا تخلّف عن طريق النجاة، لا تنفعه حينئذٍ تلك الصلاة ، فيكون حاله كحال الصائم الذي ليس له من صيامه إلاّ الجوع والعطش ؛ لأنّ الغاية من الصيام هي الشعور
ص: 395
بمعاناة الفقراء والتحنّن إليهم واكتساب القدرة على الصبر والشعور بالمسؤولية ، فإذا ابتعد الصائم عن هذه الغاية انتفى صيامه، فكم من صائمٍ لم تتحقّق لديه الغاية من أداء فريضة الصيام، فهو ليس بصائمٍ بالمعنى الغائي .
من هنا كان تفسير الإمام الصادق للفظة «المصلّين» بدلالة الاتّباع، تفسيرا منطقيا وإبانة عقلية لها من النصّ القرآني ما يؤيّدها ويعضدها ؛ لأنّ العمل الصالح لا بدّ فيه من اقتداء واقتفاء، حيث قيّض اللّه تعالى لكلّ أُمّة هداة وأشياع يشقّوا الطريق لأُولئك الناس الذين يرومون النجاة والعبور إلى ضفة الأمان، فكان من الواجب العقلي والتكليفي معا أن يتّبع مَن يرجو السلامة .
هؤلاء الأشياع «الأئمّة في أُمّة الإسلام»، فما من نبيّ مُرسل إلاّ جعل اللّه له خلفاء يقودون الناس من بعده، فلا بدّ لكلّ سلف موكّل من خلف يحمل على عاتقه ثقل الأمانة ويؤدّيها على أكمل وجه، وكل من تخلّف عن هذه النخبة سلك السبيل المخالِف .
فليس غير الحقّ إلاّ عدم الحقّ، من هنا سُلِكَ من ضلّ عن التبعية في سقر ؛ لأنّه لم يكن من التابعين للسابقين «الحقّ الأمثل» بلا تشكيك أو تردّد ، فليس التجافي عن أداء الصلاة مدعاة إلى دخول سقر، بقدر ما يدعو ترك الحقّ أصالة الدخول إلى ذلك المكان الذي لا يدخله إلاّ كلّ من تخلّف عن اتّباع الحقّ والتمسّك به .
من تتبّعنا للنصوص الروائية التي جاد بها الكليني وأحصاها ورتّبها على وفق موضوعاتها والتي ضمّنها الأئمّة منهج تفسير القرآن بالقرآن، يمكن أن نصل إلى قناعة تنصّ على أنّ استعمال الأئمّة عليهم السلاملمنهج تفسير القرآن بالقرآن في مروياتهم، وسبق الرسول صلى الله عليه و آله إلى استعمال هذا المنهج قبلهم، يدلّ دلالة قطعية على صحّة تطبيق هذا المنهج في الوصول إلى صدق الدلالة المرادة في النصّ القرآني ، فليس أصدق من تفسيره سبحانه إلى كتابه، وما وظيفة الإمام أو المفسّر المستعمل لهذا المنهج إلاّ وظيفة المتأمّل والمفكّر في نصوص القرآن لبيان مدلولات نصوصه الأُخرى من خلال
ص: 396
تفعيله جدلية عرض الدلالة المبهمة في نصّ قرآني على الدلالة المُوضّحة في نصّ قرآني آخر .
ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام في حقّ القرآن تأسيسا على هذا المضمون : «ذلك القرآن فاستنطقوه»(1)، وقوله أيضا : «ينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض»(2) .
فالاستنطاق يُحمَل على معنيين :
الأوّل : إنّ النصّ القرآني ينطق عن بعضه بعضا، أي أنّه يفسّر نفسه بنفسه، فإذا ما تدبّرتم به وتأمّلتم فيه مرارا وتكرارا ، فسوف تجدونه ينطق لكم في موضعٍ منه عمّا استُبهِم عليكم في موضعٍ آخر ، ويفصح لكم في هذا الموطن عمّا اختزله في موطنٍ آخر .
أمّا المعنى الثاني : فهو عملية طلب استنطاق القرآن عن مدلولاته من خلال توظيف الجهد الفكري للعقل البشري ، فالنصّ كان وما زال خطابا ثابت المبنى متحرّك المعنى، وعلى العقول أن ترتشف منه الدلالات والمضامين، ولكن مهما اجتهدت العقول في ذلك فإنّ النصّ يبقى فوق مستوى الاستقاء الدلالي ؛ لأنّ النصّ يمثّل أعلى درجات العمق الدلالي والبعد الغائي قياسا إلى عقول البشرية .
فالعقل مُحدّد وإن أثمر وأنتج ، والنصّ مطلقٌ وإن استُفيد منه معنىً ودلالةً ، من هنا كانت ثمّة علاقة جدلية بين العقل «المُستَثمِر الدلالي» وبين النصّ «ميدان الاستثمار ومَوئل الجُهد العقلي» . وتأسيسا على هذه العلاقة وجب الاستنطاق للنصّ على مسار الخطّ الزمني الذي يعيشه العقل الإنساني .
أمّا نصّ الإمام الآخر فهو أوضح من أن يُتحدّث فيه ، فالنصّ ينطق عن نفسه ويشهد على بعضه بعضا بأنّه من اللّه تعالى، وهذا يفضي بنا إلى القول بأنّ منهج تفسير القرآن بالقرآن يدلّ دلالةً قاطعةً على أنّ الخطاب القرآني هو من عند اللّه تعالى، وأنّه
ص: 397
ليس من صنع البشر البتّة ، فقد حَسِبَ سبحانه لكلّ شيء حسابه، ووضع كلّ مفردة في موضعها بهندسة عالية الدقّة، وبراعة منقطعة النظير، فجاء التعبير المقدّس وحدةً واحدةً، فما غَمُضَ في مكانٍ جاء توضيحه في مكانٍ آخر، وما اختُزِل في موضعٍ ورد تفصيله في موضعٍ آخر ؛ ولهذا قيل - تسالما - : «مَن أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أوّلاً من القرآن، فما أُجمِل منه في مكانٍ فقد فُسّر في موضعٍ آخر، وما اختُصر في مكانٍ فقد بُسط في موضعٍ آخر منه»(1) .
فإذاً، ما كان النصّ قطعة فنّية رائعة متكاملة الأجزاء متعاضدة الروابط، فإنّ هذا لدليل على إعجازه، ولحجّة بيّنة على أنّه من وحي السماء، ولا دخل للبشر في صياغته أو نسجه ؛ إذ لا يقوى البشر على ذلك ولا يكادون ، وقد أبان سبحانه هذه الحقيقة الثابتة بقوله : «أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا»(2) .
وهنا لا بدّ من الإيضاح - ونحن ما زلنا في هذا الشأن - من أنّ منهج تفسير القرآن بالقرآن الذي اتّبعه الأئمّة عليهم السلام والمفسّرون من بعدهم - سواء أ وُجِدَ آثار ذلك في كتاب الكافي، أم في غيره - يكمن في أن ترد لفظة مبهمة أو تركيب مبهم في نصٍّ قرآني، ويرد تفسيره وبيانه في نصٍّ قرآني منفصل عنه، سواء أكان في السورة ذاتها أم في غيرها من سورة .
أمّا أن يرد لفظ مبهم في نصٍّ ويرد بيانه في ذات النصّ نفسه، فإنّ هذه الحيثية في البيان لا تعدّ من باب تفسير القرآن بالقرآن ، ذلك بأنّ هذا النمط «بيان النصّ لنفسه» لا يصدق عليه مصطلح التفسير ، وإنّما يصدق عليه مصطلح البيان ؛ لأنّ «البيان» مصطلح أوسع نطاقا من التفسير، فالتفسير يدخل ضمن نطاق مصطلح البيان، ليكون البيان
ص: 398
بهذا يضمّ التفسير وزيادة . فكلّ تفسير بيان بالضرورة، وليس كلّ بيان تفسير بالضرورة .
فعلى الرغم من أنّ تفسير المفردة في ذات الآية يعدّ إيضاحا لتلك المفردة وبيانا لها، إلاّ أنّه لا يمكن أن نعده من باب تفسير القرآن للقرآن ؛ لأنّ قرائن النصّ تبيّن بعضها بعضا في نسق كلامي معيّن، فالسياق النصّي للآية له حاجة مُلحّة لهذه الموضّحات، فتكون هذه القرائن البيانية من مقتضيات البناء التكاملي لمضمون النصّ الواحد ، ومن دونها يحال النصّ إلى مجموعة من الرموز والإشارات التي لا يمكن معرفتها .
من هنا تحتّم على المتكلّم أن يورد هذه الإيضاحات في موضعٍ واحد لبيان دلالة تلك الآية بوضوح ، إذ مرتكز الحديث يُناط بذكر تلك اللفظة الموضّحة، وبرفعها يختلّ المعنى وتتصدّع الدلالة، ويشوب النصّ شيء من الغموض غير المسوّغ .
من هنا نقرّر أنّ عملية إيضاح النصّ من داخله لا تعدّ من باب تفسير القرآن بالقرآن، وأنّ ما يصدق عليه منهج تفسير القرآن بالقرآن هو ما كان إيضاح المبهم فيه من خارج نصّه ؛ لأن إيضاح النصّ من داخله ضرورة مُلحّة ومكملات واجبة لبيان النصّ ذاته . وبمعنى آخر أنّ دلالة النصّ والغاية منه تتوقّف على ذكر تلك الأداوت الموضّحة داخل النصّ، وبانتفائها تنتفي الغاية التي سيق من أجلها النصّ بأسره كما تبيّن ذلك ، أمّا المبهم الذي يُساق في نصّ ويرد تفسيره في نصٍّ آخر ، فإنّ هذا يدلّ على أنّ عدم إيضاح ذلك المبهم في النصّ ذاته لا يعدّ ضرورة يتوقّف عليها النصّ، وإنّما يمكن إرجاء البيان إلى نصٍّ آخر، ولا غضاضة في هذا البتّة ؛ بل يُنظر إليه على أنّه إبداع نصّي وقدرة بيانية عالية على سبك المضامين ، وجودة ترتيب أجزاء النصّ على أساس المبهم، وبيان ذلك المبهم ليكون كلُّه كُلاًّ واحدا مُوحّدا لا اختلاف فيه البتّة .
ص: 399
من خضم النظر والتأمّل في طيّات كتاب الكافي ومسايرة جهود الشيخ الكليني وإجاداته، توصّل الباحث إلى جملة نتائج وثمرات يمكن أن نلخصها على النحو الآتي :
1 - وجد الباحث أنّ كتاب الكافي لا يمثّل منبعا لاستقاء المعرفة الفقهية وإقرار الدلالات الشرعية فحسب ، بل يمكن النظر إليه على أنّه أحد مصادر إنتاج الدلالة التفسيرية، وموردا من موارد صيرورة وتكوين منهج تفسير القرآن بالقرآن، ومنهج التفسير الأثري في وقتٍ معا ، فالكثير من المرويات التي نقلها الكليني عن الأئمّة عليهم السلام تنطوي على مقدارٍ ليس باليسير من بيانات النصّ القرآني وإيضاح دلالاته الخفية ، التي لا يمكن أن تظهر على سطح النصّ ابتداءً .
وقد وظّفَ الأئمّة عليهم السلام منهج عرض الآية على أُختها في مسلكهم البياني؛ لكشف الإبهام والغموض في التعبير المقدّس ، فكان عملهم هذا يتضافره نمطان من أنماط المناهج التفسيرية المعروفة في الوقت الحالي، ألا هما «منهج تفسير القرآن بالقرآن»، وذلك من حيث الأداء التطبيقي للرواية التفسيرية، و «منهج التفسير بالأثر»، وذلك من حيث عملية نقل النصّ التفسيري «الروائي» عنهم عليهم السلام .
2 - إنّ اعتماد الأئمّة عليهم السلام على منهج تفسير القرآن بالقرآن في عدد غير قليل من روايتهم التفسيرية، يؤشّر لنا إيمانهم المطلق بمصداقية هذا النمط التفسيري في الكشف عن مكنونات النصّ المعجز واستنطاق دلالاته ، ذلك بأنّ كاشف المعنى في هذا النطاق هو الذات المتكلّمة نفسها ، ولمّا كان اللّه سبحانه هو الأعلم مطلقا بمرادات كلامه، كان اتّباع هذا النمط التفسيري من قبل الأئمّة عليهم السلام هو الأنجع - عموما - في شقّ الطريق للوصول إلى الدلالة النصّية وإثباتها يقيناً دون تردّد أو تشكيك .
3 - استشفّ الباحث من استطلاعه للروايات التفسيرية التي سلك فيها الأئمّة عليهم السلام
ص: 400
منهج «تفسير النصّ بالنصّ»، أنّ أغلب هذه الرويات تنصّ على إزاحة الغموض عن النصوص ذات الدلالات التشريعية، كحرمة الخمر، وتحديد مقدار القطع من يد السارق، ونظرائها ، وهذا يعبّر عن مدى تحسّس الأئمّة للجانب التكليفي في النصّ القرآني، فضلاً عن رغبتهم الشديدة وموقفهم التوكيلي في إبانة هذا النمط الدلالي من القرآن الكريم ، ذلك بأنّ الجمع لهم حاجة إلى من يرشدهم إلى غايات المراد الإلهي لأداء المطلوب ، لذا اعتنى الأئمّة عليهم السلام بهذا الجنس المضموني انطلاقا من مبدأ العدالة الإلهيّة التي من مضانها قاعدة «أنّ التكليف بالمبهم من المحال عقلاً ومنطقا» .
4 - وصل الباحث إلى قناعة قادته إلى القول بأنّ عملية بيان القرآن بالقرآن تجري عمليا على نمطين: الأوّل: عملية بيان اللفظ المبهم في ذات النصّ الذي سيق فيه ذلك المبهم ، أمّا الثاني: فهو عملية بيان مبهم النصّ من نصٍّ آخر منفصل عن النصّ المبهم اعتمادا على منطق «البيان من الخارج» ، وهذا النمط الأخير هو الذي يصدق عليه تسمية «منهج تفسير القرآن بالقرآن» ؛ لأنّ النمط الأوّل من البيان القرآني يعدّ فيه البيان من موجبات تمام دلالة النصّ، وباقصاء هذه البيانات يحال النصّ إلى مجموعة رموز وإشارات غير مفهومة ، ولا يمكن - والحال هذه - إجراء عملية إبانة خارجية لهذه الرموز من نطاق خارج النصّ ؛ ذلك بأنّ أجزاء النصّ «المرمّز» غير متكاملة أساسا حتّى تجري عملية إبانتها من الخارج ، فيجب أن يتكامل النصّ دلالةً ومنطقا ابتداءً ، ويرد فيه شيء مبهم حتّى يتسنّى إعمال تفسيره وبيانه من نطاق خارج النصّ أو من نصٍّ آخر منفصل عنه .
ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : «وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ»(1)، فلو حذفتَ لفظة «لاعبين» من الآية الكريمة - وهي من أدوات البيان الإيضاحي بوصفها حالاً تأسيسا - ، لاختلّ المعنى ولأصبح الخطاب ناقصا يحتاج
ص: 401
إلى تتمّة ، بل سيحال النصّ إلى رموز مبهمة كلّية ، ومثله قوله تعالى : «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَارَیٰ»(1)، فلو رفعت عبارة «وأنتم سكارى» لانقلب المعنى المراد تماما ، ولفُهم أنّ اللّه تعالى ينهى عن الصلاة نفسها، وليس النهي واقعا على أداء الصلاة في حال السكر ، فأعطت الآية بهذا الحذف ل «البيان القيدي» المعنى الضدّ أو الدلالة المعاكسة لما أراده اللّه تعالى من هذا النصّ، فيكون النصّ بهذا مبهماً أيضا؛ لتقاطعه مع النصوص التي تثبت وجوب الصلاة .
من هنا كان وجود أدوات البيان داخل النصّ نفسه أمرا تقتضيه الصيرورة الدلالية العامّة للنصّ، وبانتفاء هذه الأدوات ينتفي تكوّن الدلالة العامّة التي يسعى النصّ لبنائها وإيصالها للمتلقّي ، لذا كان الوجود البياني الداخلي ها هنا واجبا ، وبهذا لا يعدّ هذا النمط البياني من باب تفسير القرآن بالقرآن ؛ لأنّه بيانٌ واجب الوجود في النصّ ،من هنا نقرّر أنّ منهج تفسير القرآن بالقرآن لا يكون إلاّ بإبانة للمبهم النصّي من نصٍّ منفصل عنه خارج عن نطاقه البتّة .
5 - إنّ منهج تفسير القرآن بالقرآن يمثّل دفعةً جادةً نحو الحِراك الفكري وممارسة التأمّل العقلي في النصّ القرآني، والقدرة على ربط الجزئيات بعضها ببعض من أجل إنتاج الدلالة التفسيرية لذلك النصّ المعجز ، فاتّباع الأئمّة عليهم السلاملهذا المنهج في كتاب الكافي ما هو إلاّ دعوة صريحة إلى استعمال العقل البشري في بناء البيان الدلالي للخطاب المقدّس .
فكثير من إبهامات القرآن جرى إيضاحها بالقرآن نفسه، وما على الناظر فيه إلاّ التأمّل والتأنّي حتّى يتسنّى له التقاط الدلالة ولملمتها تكميلاً لتحقّق تكاملها .
وبالمحصّلة، فإنّ كثرة النظر في النصّ القرآني تولّد قدرةً عاليةً على شدّ الوشائج النصّية وإعادة قراءتها على أساس الإبهام وعلاقته الجدلية بالبيان المنفصل عنه نصّاً لا
ص: 402
تكاملاً ، ومن ثمّة تسهم هذه العملية في حلّ الكثير من الإشكالات الواقعية التي يعيشها الإنسان ، ذلك بأنّ سلوك منهج تفسير النصّ بالنصّ واعتماد حيثية ربط الجزء بما يوضّحه، يمثّل جزءا مهمّا من منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، وهذا الأخير يسهم بفاعلية عالية على انتزاع الحلّ الأمثل من النصّ المعجز من أجل معالجة الواقع الإنساني المعاش .
وبهذا يعدّ انتهاج مبدأ تفسير الخطاب بالخطاب موردا من موارد الحلّ الموضوعي من القرآن «المُعالِج» إلى الواقع «المُشكِل» ، ومن هنا يمكن النظر إلى هذا المنهج التفسيري على أنّه جزء من الحلّ لبعض مشاكل الإنسان ، وفي هذا تكمن
أهمّيته الحقيقية وتظهر مكانته الحقّة .
ص: 403
1 . القرآن الكريم .
2 . الاءتقان في علوم القرآن ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 ه ) ، تحقيق : سعيد المندوب ، بيروت : مطبعة دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 1416 ه .
3 . إرشاد الفحول ، محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني (ت 1250 ه ) ، مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، الطبعة الأولى .
4 . الأُصول العامّة للفقه المقارن ، محمّد تقي الحكيم ، قمّ : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام ، الطبعة الثانية ، 1390 ه .
5 . البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين محمّد بن عبد اللّه الزركشي ، تحقيق : محمّد أبو الفضل
إبراهيم ، بيروت : دار المعرفة ، 1391 ه .
6 . التبيان في إعراب القرآن ، عبد اللّه بن الحسين العُكبَري ، الرياض : بيت الأفكار الدولية .
7 . التبيان في تفسير القرآن ، أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي (ت 460 ه ) ، تحقيق : أحمد حبيب قصير العاملي ، قمّ : مكتبة الإعلام الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1379 ه .
8 . تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل) ، ناصر الدين أبو سعيد عبد اللّه بن عمر (ت 685 ه ) .
9 . تفسير العيّاشي ، أبو النضر محمّد بن مسعود السلمي السمرقندي المعروف بالعيّاشي (ت 320 ه )، تحقيق : هاشم الرسولي المحلاّتي ، طهران : المكتبة العلميّة ، الطبعة الاُولى ،
1380 ه .
10 . تفسير القرآن بالقرآن ، ياسر كاصد الزيدي ، (بحث منشور في مجلّة آداب الرافدين ،
ص: 404
جامعة الموصل) ، العدد : 12 .
11 . التفسير الكبير و مفاتيح الغيب (تفسير الفخر الرازي) ، أبو عبد اللّه محمّد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي (ت 604 ه ) ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، 1420 ه .
12 . التفسير لكتاب اللّه المنير ، محمّد الكرمي الحويزي ، قمّ : المكتبة العلمية ، 1402 ه .
13 . تفسير الميزان (الميزان في تفسير القرآن) ، محمّد حسين الطباطبائيّ (1402 ه ) ، طهران : دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الثالثة ، 1397 ه .
14 . الجديد في تفسير القرآن ، محمّد بن حبيب اللّه السبزواري النجفي ، بيروت : دار التعارف للمطبوعات ، 1406 ه .
15 . الجوهر الثمين ، السيّد عبد اللّه شبّر (ت 1242 ه ) ، الكويت : مكتبة الألفين ، الطبعة الأولى ، 1407 ه .
16 . دروس في المناهج والاتّجاهات التفسرية للقرآن ، محمّد علي رضائي ، تعريب : قاسم البيضاني ، قمّ : مطبعة صدف ، الطبعة الأولى ، 1426 ه .
17 . دلالة الحال في التعبير القرآني بين التأسيس والتأكيد ، سيروان عبد الزهرة هاشم الجنابي (بحث منشور في مجلّة القادسية / جامعة القادسية) ، العددان (3 و 4) ، 2006 م .
18 . روح المعاني في تفسير القرآن (تفسير روح المعاني) ، أبو الفضل شهاب الدين السيّد محمود الآلوسي (ت 1270 ه ) ، تحقيق : محمّد السيّد الجليند ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ،
الطبعة الثانية ، 1404 ه .
19 . السنّة النبويّة ومكانتها في التشريع ، عبّاس متولّي حمادة ، القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر .
20 . الصافي في تفسير القرآن (تفسير الصافي) ، محمّد محسن بن شاه مرتضى (الفيض الكاشاني) (ت 1091 ه ) ، مشهد : دار المرتضى للنشر ، الطبعة الأولى .
21 . علوم القرآن الكريم ، غانم قدّوري حمد ، بغداد : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مطبعة دار الحكمة ، 1990 م .
ص: 405
22 . فقه القرآن في شرح آيات الأحكام ، سعيد بن هبة اللّه المعروف بقطب الدين الراوندي (ت 573 ه ) ، قمّ : مكتبة آية اللّه مرعشي النجفي ، 1405 ه .
23 . قضايا لغوية قرآنية (دراسات نظرية وتطبيقية في المنهج الأُصولي لتحليل النصّ القرآني) ، عبد الأمير كاظم زاهد ، بغداد : مطبعة أنوار دجلة ، الطبعة الأولى ، 1424 ه .
24 . الكافي ، أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب
بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329 ه ) ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، طهران : دارالكتب الإسلامية ، الطبعة الثانية ، 1389 ه .
25 . كتاب العين ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175 ه ) ، تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال .
26 . الكشاف عن حقائق التنزيل ، محمود بن عمر الزمخشري (ت 538 ه ) ، تحقيق : عبد الرزّاق المهدي ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية ، 1421 ه .
27 . مباحث في علم التفسير ، عبد الستّار حامد ، بغداد : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1990 م .
28 . المبادئ العامّة لتفسير القرآن الكريم ضمن كتاب (دراسات قرآنية) ، محمّد حسين علي الصغير ، مكتب الإعلام الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 1413 ه .
29 . مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمّد عبد العظيم الزرقاني ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ، بيروت : دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 1996 م .
30 . مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، عبد الأعلى السبزواري ، مؤسّسة أهل البيت عليهم السلام ، بيروت ، 1309 ه .
31 . نهج البلاغة ، علي بن أبي طالب عليه السلام ، تحقيق : الشيخ محمّد عبده ، بيروت : دار المعرفة .
ص: 406
الأثر التفسيري في روايات «الكافي»
كتاب الزكاة أُنموذجا
عدي جواد الحجّار
الحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين ، وعلى آله الطيّبين الطاهرين ، وعلى صحبه المنتجبين ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .
لا شكّ أنّ القرآن الكريم هو الكتاب المقدّس الذي أنزله اللّه تعالى على خاتم المرسلين صلى الله عليه و آله هدايةً للناس فيما يتعلّق بالنشأتين ، فهو كتاب هداية وإرشاد ومنهج للحياة ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن جعله إمامه قاده إلى الجنّة ، ومن دعا إليه هُدي إلى صراطٍ مستقيم ، ومن اجتهد في تلاوته وفهم معانيه والعمل بأحكامه فقد فاز فوزا عظيما، فهو حبل اللّه المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا يشبع منه العلماء .
ولا جرم أنّ تفسير القرآن الكريم أشرف العلوم وأجلّها قدراً ، حيث إنّ موضوعه كلام اللّه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد . ولذا فإنّ خير الجهود ما صُرفت في تفسير القرآن الكريم وبيان أحكامه وذكر عجائبه ، وكشف ما ضمّ من أسرار .
ولقد كان النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله المفسّر الأوّل للقرآن الكريم ، كما عهد إليه اللّه سبحانه
ص: 407
وتعالى ، بقوله : «وَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»(1) ، ونهض من بعده أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، فهم الراسخون في العلم ، وهم عدل القرآن الذي أكّد عليه النبيّ صلى الله عليه و آله في مواقف عديدة ، وعلى رأسهم أوّل من تكلّم في تفسير القرآن بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، وهو أعلم المسلمين بكتاب اللّه وتأويله بلا مدافع ، بل هو باب مدينة العلم .
عن ابن مسعود أنّه قال :
إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلاّ وله ظهر وبطن ، وإنّ عليّا عنده من الظاهر والباطن(2) .
وسار على منهجه الأئمّة المعصومون عليهم السلام من بعده ، فكانوا حملة القرآن ودعاة القرآن ومفسّري القرآن، كما كانوا عدل القرآن(3) .
ولمّا كان الكليني قد جمع الكثير ممّا روي عن أهل بيت العصمة عليهم السلام ، استدعى ذلك تتبّع هذه الروايات والنظر فيما حملته من التفسير ، وإن كان ترتيبها بحسب تبويبٍ يبتعد في نهجه عن المنحى التفسيري التسلسلي ، إذ إنّ هذه الروايات التفسيرية قريبة في ترتيبها للتفسير الموضوعي ، وإن لم يكن مقصوداً .
وقد أخذ البحث "كتاب الزكاة" أُنموذجا لما يفترضه من وجود ذلك المنحى التفسيري ، ومحاولاً تسليط بعض الضوء على جملة من البيان التفسيري في آيات فسّرتها روايات رواها الكليني عن المعصومين عليهم السلام ، واستعراض بعض ما جاء في تلك الآيات من البيان لدى مفسّري جمهور المسلمين ، ليتّضح مدى فائدة الانتهال من علوم أهل البيت عليهم السلام ، وعدم إحاطة غيرهم بكثير من المعاني ، إن لم يخبطوا فيها .
اقتضت طبيعة البحث على اشتماله على مقدّمة مقتضبة ، والتعريف بالكليني
ص: 408
وكتابه الكافي ، وتمهيد مختصر لعرض أُطروحة البحث في بيان الأثر التفسيري في روايات الكليني في كتابه الكافي، ثمّ اختار البحث بعض الموارد التفسيرية من كتاب الزكاة بيّن فيها المعصوم عليه السلام مراد اللّه تعالى ، كالبيان التفسيري المرادف للفظٍ قرآني ، أو بيان دلالة مفردة ، أو بيان ضابطة في التمييز بين صنفين ، أو بيان تفسيري بتقدير متعلّق ، أو بيان الفرد أو المصداق الأظهر ، مع توخّي الاختصار ، ثمّ جاء البحث على ذكر النتائج التي تمخّض عنها ، ثمّ كشفا بالمصادر والمراجع التي استند إليها ، فجاء على النحو الآتي :
هو أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي البغدادي، ويُعرف أيضا بالسلسلي؛ لنزوله درب السلسلة ببغداد . و«الكليني» نسبة إلى كلين، كزبير، قرية في دهستان فشافويه من ناحية الري. ويظهر أنّ نشأته الاُولى كانت في «كلين» ، ثمّ توجّه إلى بغداد لطلب العلم، حتّى توفّي فيها ، فإنّ والده يعقوب كان من علماء الري ساكناً في كلين ودُفن فيها، وصار قبره معروفاً مشهوراً يُزار(1) .
قال النجاشي :
شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنّف الكافي الكبير في عشرين سنة ، توفّي ببغداد سنة تناثر النجوم، وهي سنة : 329 ه (2) .
وقال الطوسي :
جليل القدر عالم بالأخبار، ودُفن الكليني بباب الكوفة في مقبرتها ، قال ابن عبدون: رأيت قبره في صراة الطائي وعليه لوح مكتوب عليه اسمه(3) .
ص: 409
وقال ابن طاووس :
الشيخ المتّفق على ثقته وأمانته(1) .
وعن ابن الأثير :
هو الفقيه الإمام على مذهب أهل البيت، عالم في مذهبهم، كبير، فاضل عندهم
مشهور ، وعدّه في حرف النون - من كتاب النبوّة - من المجدّدين لمذهب الإمامية على رأس المئة الثالثة(2) .
وقال ابن حجر :
هو من فقهاء الشيعة والمصنّفين على مذهبهم(3) .
وقال ابن ماكولا :
الكليني - بضمّ الكافّ وإمالة اللاّم وقبل الياء نون - فهو أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي، من فقهاء الشيعة والمصنّفين في مذهبهم(4) .
«الكافي» :
شهد بحقّه الشيخ الأجلّ المفيد (ت 413 ه ) ، قائلاً :
كتاب الكافي وهو من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة(5) .
فهو المنهل العذب الصافي ، لم ينسج ناسج على منواله ، وقد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعية والأسرار الدينية ما لا يوجد في غيره(6) . وهو مستغنٍ عن الإطراء ؛ لأنّ الكليني - رضي اللّه عنه - إن لم يكن قد كتبه تحت نظر الأئمّة عليهم السلام ، فلا أقلّ من أنّه كتب بمحضر من نوّاب الحجّة عليه السلام ، وكلاء مولانا المهدي عليه السلام : عثمان بن
ص: 410
سعيد العمري ، وولده أبي جعفر ، وأبي القاسم حسين بن روح ، وعلي بن محمّد السمري رضي اللّه عنهم .
وتوفّي محمّد بن يعقوب قبل وفاة محمّد بن علي السمري رضي اللّه عنه ، وقد سأله بعض الشيعة تأليف كتاب الكافي؛ لكونه بحضرة من يفاوضه ويذاكره ممّن يثقّ بعلمه ، حتّى حكي أنّه عُرض على المعصوم عليه السلام ، فقال: «كافٍ لشيعتنا»(1) .
التزم الكليني في كتابه الكافي أن يذكر في كلّ حديث - إلاّ نادراً - جميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم عليه السلام ، وقد يحذف صدر السند ولعلّه نقله عن أصل المروي عنه من غير واسطة ، أو لحوالته على ما ذكره قريباً ، وهذا في حكم المذكور(2) .
وحُصرت جميع أحاديثه في (16169) حديثا ، الصحيح من هذه الأحاديث - بحسب الاصطلاح - (5072) حديثا ، والحسن (144) حديثا ، والموثّق (1118) حديثا ، والقوي منها (302) حديثا ، والضعيف منها (9485) حديثا . وجملة هذه الأحاديث موزّعة على (34) كتابا ، و(326) بابا ، ضمّت الكثير من العلوم الدينية التي لم يحوها غيره في الأُصول والفروع والتفسير وغيرها(3) .
لا شكّ أنّ كتاب الكافي من المجاميع الحديثية الجليلة التي لها الأثر البالغ في الاستدلال في إثبات العقائد ، والفروع الفقهية ، والآداب الشرعية ، فضلاً عمّا حمله من مسائل تهمّ سائر الأُمور الدينية والدنيوية .
ولو نظر أيّ مشتغلٍ بحقلٍ من حقول المعرفة على اختلاف أنواعها ، يجد أنّ
ص: 411
الكثير من الروايات تتّصل بتخصّصه بمقدارٍ ما ، وتوضّح الكثير من الغوامض ، فضلاً عمّا جاء متخصّصا من أوّل الأمر لدى إجابة أحد المعصومين عن مسألة بعينها في مجالٍ خاصّ .
إلاّ أنّ النهج الذي اتّبعه الشيخ الكليني في تبويب الروايات، جعلها متناثرة في أبواب تتعلّق بحكمٍ شرعي أو مسألةٍ أُخرى بحسب ما يقتضيه الباب ، هو ممّا يُشكر من جهود الشيخ الكليني ؛ لما فيه من تسهيل تناول الروايات على حسب الكتب والأبواب التي رتّبها جزاه اللّه خيراً .
وهو المنهج الذي اتّبعه بعض أعلام المحدّثين في تصنيفاتهم الروائية ممّن سبقه ، وهو لا ينافي إفادة هذه الروايات إفادات متخصّصة ، إذ بإمكان الباحث الفحص عمّا يعنيه ، ليستله من هذه الروايات .
ومن الروايات التي لها كبير الأثر في العلوم الدينية ما يجده الباحث في علوم التفسير ، وبصورةٍ أدقّ في تفسير آيات الأحكام ، أو تلك الآيات التي توظّف لبيان الحكم الشرعي ، أو تكون من الشواهد التفسيرية التي تدعم الاستدلال على الحكم الشرعي، وإن لم تكن آية حكم في النظر الأوّلي ، إذ يتّضح الأثر التفسيري من خلال تتبّع روايات الكافي لدى مقارنتها مع البيانات التفسيرية التي انتظمتها كتب التفسير عند جمهور المسلمين عموما ، وعند مفسّري الإمامية بوجهٍ خاصّ .
ولا شكّ أنّ القرآن الكريم هو الكتاب المقدّس الذي أنزله اللّه تعالى على خاتم المرسلين صلى الله عليه و آله ، هدايةً للناس فيما يتعلّق بالنشأتين ، وهو موضوع علم التفسير الذي تولاّه الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ، كما عهد إليه اللّه سبحانه وتعالى بقوله : «وَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»(1) ، فالتفسير وظيفته ووظيفة أئمّة أهل
البيت عليهم السلام من بعده ، فهم الراسخون في العلم ، وهم عدل القرآن الذي أكّد عليه
ص: 412
النبيّ صلى الله عليه و آله في مواقف عديدة ، وعلى رأسهم أوّل من تكلّم في تفسير القرآن بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، وهو أعلم المسلمين بكتاب اللّه وتأويله بلا مدافع ، بل هو باب مدينة العلم .
عن ابن مسعود أنّه قال :
إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلاّ وله ظهر وبطن ، وإنّ عليّا عنده من الظاهر والباطن(1) .
وهكذا أولاده المعصومون الذين هم نفس رسول اللّه ، وهم المقصودون بالإفهام ، لما كلّفهم اللّه تعالى من قيادة المجتمع وإقامة أحكامه ، وبيان مراده تعالى .
فلا غرو أن يجد الباحث أنّ تفسيرات أئمّة أهل البيت عليهم السلام التي وردت في روايات أصحابهم ، قد حملت معاني وبيانات تفسيرية لها الشأن الأكبر والحظّ الأوفر في إيضاح المراد وإيصاله إلى أفهام عموم الناس ، فقد يرى الباحث عبارة من تفسير المعصوم مختصرة في ألفاظها ، مبسوطة في معانيها، غنية في مدلولاتها ، لا تدانيها عبارات مسهبة تدور حول المعنى، وربّما لا تصل إليه طالما ابتعدت عن المنهل الذي جعله اللّه تعالى الشرعة والمنهاج . وقد تحيط عبارة من عبارات الإمام في تفسير مفردة في آية بكلّ عبارات من تصدّى للتفسير من جمهور المسلمين .
وسيقف البحث عند بعض هذه البيانات التفسيرية ، من خلال أُنموذج من الكتب التي جمع فيها الكليني روايات أهل البيت عليهم السلام ، ألا وهو «كتاب الزكاة» ، حيث ضمّ هذا الكتاب تسع عشرة آية قرآنية، عدا المتكرّر منها ؛ ليدلّل على ما يزعم البحث ، وهو «الأثر التفسيري الواضح لروايات الكافي» .
وبعض هذه الروايات اشتمل على آية أو آيات كشاهد للحكم ، بيد أنّ بعض الروايات كان الأصل فيها سؤال من أحد الأصحاب عن تفسير آية ، ولمّا ضمّت هذه الآية ما ينفع في أحد أبواب الزكاة، عمد الشيخ الكليني لإدراجها في بابها الخاصّ.
ص: 413
فقد تضمّنت هذه الروايات بيانات تفسيرية ، مثل :
ما رواه الكليني من سؤال صفوان الجمّال للإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام عن معنى «المحروم» في قوله تعالى : «وَ الَّذِينَ فِى أَمْوَ لِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُومِ»(1) ، بسنده عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في تفسير قوله عزّ وجلّ : «لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُومِ» قال : «المحروم المحارف الذي قد حرم كدّ يده في الشراء والبيع»(2) .
وفي رواية أُخرى ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام أنّهما قالا : «المحروم : الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق، وهو محارف»(3) .
وهو بيان لغوي لمفردة «المحروم» التي وردت في الآية ، وبيان تفسيري لغوي لمرادفها «المحارف» بعد أن حار فيه كثير من المفسّرين ، فجلاه الإمام بعد أن كان غامضا قد خبط فيه الكثيرون ، قال الشعبي (ت 103 ه ) : «أعياني أن أعلم ما المحروم»(4) ، إذ فسّر بأنّه «الذي لا سهم له من الغنيمة ، وقد ضعّف هذا القول ؛ لأنّ السورة مكّية ، والغنائم كانت بعد الهجرة»(5) ، كما وردت فيه عدّة تفسيرات ، منها :
1 - الذي يُحسب غنيّا فيُحرم الصدقة لتعفّفه .
2 - الذي تبعد منه ممكنات الرزق بعد قربها منه، فيناله الحرمان .
3 - المحارب الذي ليس له في الإسلام سهم مال .
4 - الذي أُجيحت ثمرته .
5 - الذي ماتت ماشيته .
ص: 414
6 - الذي لا ينمي له مال .
7 - الذي لا يكاد يكسب(1) .
فالمحروم في اللغة الممنوع ، والحرمان عدم الظفر بالمطلوب عند السؤال، يقال سأله فحرمه(2) ، فالمحروم في الآية منع خاصّ ، فسّروه بأنّه المحارف(3) ، ولكن ما هو المقصود بالمحارف ؟
فالمحارف بالفتح ، أصله من «حرف»، و «الحاء والراء والفاء ثلاثة أُصول حدّ الشيء والعدول وتقدير الشيء»(4) :
1 - فأمّا الحدّ فحرف كلّ شيء حدّه، كالسيف وغيره ، ومنه الحرف وهو الوجه .
2 - الانحراف عن الشيء .
3 - حديدة يقدّر بها الجراحات عند العلاج .
وزعم ناس أنّ المحارف من هذا الأصل الثالث، كأنّه قدّر عليه رزقه كما تقدّر الجراحة بالمحراف(5) .
ولعلّ أُصول هذه المادّة كلّها تدلّ على المعنى المراد في الآية ، فإنّ المحروم من حُدّد رزقه ، وعُدِل به عن المتعارف فمال عن خطّ الرزق ، وقدر عليه ، ويجمعها تفسير الإمامين عليهماالسلام بأنّه الذي قد حرم كدّ يده في الشراء والبيع ، وليس بعقله بأس، ولم يُبسط له في الرزق .
وكأنّ هذا تعريف للمحروم الذي هو المحارف ، بمعنى أنّ ميل خطّ الرزق ليس
ص: 415
من ناحية عدم الرشد ، وإنّما من أمرٍ خارج عن قدرته ، فيدخل تحته جلّ العنوانات السابقة التي ذكرها المفسّرون .
وهكذا كلام الأئمّة عليهم السلام في مقامات التفسير الأُخرى ، فهي عبارات رشيقة بليغة تبيّن ما انطوى عليه آيات كتاب اللّه تعالى من غرائب التركيب ، وإبراز النكت البيانية ،
وتجلية معاني ودلالات المفردات ، حتّى يدرك المراد منها من غمضت عليه معانيها ، أو أشكلت عليه دلالاتها .
ما رواه الكليني بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام في تفسير لفظ «الماعون» في قوله عزّ وجلّ : «وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ»(1) ، قال :
هو القرض يقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة . . .(2) .
وما رواه بسنده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام ، قوله :
والماعون أيضا ؛ وهو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه(3) .
فالأُولى رواية تفسيرية صريحة في بيان معنى الماعون ، والثانية بيان معنى الماعون استطرادا .
وفيهما أنّ الماعون عامّ يدخل فيه القرض وما يستخدم من آلات البيت ومتاعه ، وكلّ ما يصنعه الإنسان من معروف .
والثانية عموم ما ورد في الرواية الأولى، مع إطلاق المتاع وعدم تقييده بالبيت ، فيدخل تحته مطلق المتاع والآلات .
وقد دخل في جملة مفاد هاتين الروايتين ما ذكره المفسّرون من المعاني التي
ص: 416
يمكن اندراجها تحت دلالة الماعون(1) . فكان ما ذكروه كالمصاديق والأفراد لما رواه الكليني عن أبي عبد اللّه الصادق صلوات اللّه عليه .
وممّا لا يُنكر أنّ أهل اللغة الذين يرجع إليهم المفسّرون في كثير من الموارد التي تفتقر إلى معرفة الدلالة اللغوية ، يلتمسون تلك المعاني من أقوال النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله ، ومن كلام العرب العرباء ، وطالما أنّ الأئمّة عليهم السلام هم أبناء النبيّ صلى الله عليه و آله نسبا ولسانا ودينا ، بل هم نفسه ، فاتّباعهم في هذا الشأن شامل لمن قال بإمامتهم ومن لم يقل بها ، إذ هي مسألة معرفية تقتضي الموضوعية فيها الرجوع لما يطمئنّ بأنّه مقارب للحقيقة إن لم يكن يحكيها ، ولكن قد تذهب المرتكزات العقائدية بالمفسّر وغيره إلى خلاف ما يقرّه هو من القواعد .
فالماعون في اللغة : من المعونة أو اليسير ، ويقال للماء والمال ماعون أيضا(2) .
وقد ذكر المفسّرون له عدّة معان ، أوصلها القرطبي إلى اثني عشر معنى(3) ، لا تخرج في مجملها عن مفاد روايتي الكليني ، فبالجمع بين التفسير في الروايتين ، يندرج تحت المراد من الماعون أربع دلالات :
1 - الماعون : المعروف يصطنعه أو يصنعه .
2 - الماعون : إعارة متاع البيت أو مطلق المتاع .
3 - الماعون : الحقّ المالي .
4 - الماعون : القرض .
ص: 417
وظاهرٌ أنّ صنع المعروف يدلّ على ما تيسّر منه ، واصطناع المعروف لما يتكلّف السعي فيه ، وهذا يعمّ الدلالات الأُخرى ، إلاّ أنّ ذكرها جاء لنكتة تأكيدية ، وهي الإلفات إلى أنّ إعارة مطلق المتاع داخل في المعروف ، فيكون دالاًّ على الحثّ عليه .
وذكر متاع البيت تنبيه إلى دخول الحقير من المتاع في هذا المعروف ، إذ أنّ متاع البيت شامل حتّى للإبرة .
أمّا الحقّ المالي الذي عبّر عنه بالزكاة ، سواء كانت واجبة أو مستحبّة ، فالواجبة حقّ مفروض معيّن ، والمستحبّة ممّا يستحقّه المؤمن على أخيه من باب الإعانة المأمور بها ، فدخلت الزكاة في المعروف ، إلاّ أنّ ذكرها بعبارة : «ومنها الزكاة» إيذانا بأنّ الزكاة من المعروف ، ولا يقتصر الخطاب الإلهي عليها ، بل هي وغيرها من الإعانة ممّا أمر الشارع به .
أمّا القرض، فهو لا شك من وجوه المعروف، إذ هو خير من الصدقة كما هو ثابت ، ثمّ إنّ المفسّرين ذكروا من جملة معاني الماعون المال(1) ، فالقرض حينئذٍ داخل في معناه ، وكأنّ تفسير الإمام أكّد على دخوله فيه .
وعلى هذا، فتفسير الإمام صلوات اللّه عليه جاء على نحو التفصيل بعد الإجمال ، فاصطناع المعروف يدخل فيه ما ذكر من التفسير ، ثمّ فصّل بذكر بعض الأفراد التي تحتاج إلى بيان ، بيد أنّ هذا التفصيل انتظم الفرد الأضعف وهو متاع البيت ، ثمّ ترقّى إلى أفرادٍ أُخرى، مشيرا إلى دخول بعضها التي قد يتصوّر عدم دخولها ، فأكّد على مصداقٍ لم يهتدِ إليه المفسّرون ، ألا وهو أنّ الماعون بمعنى القرض ، في حين أنّه داخل تحت تفسير الماعون بالإعانة المالية ، كما تدخل الهبة والصدقة ، وهما ممّا ذكره المفسّرون(2) ، بيد أنّ القرض خير من الصدقة ، وهو إعانة مالية لها أثرها
ص: 418
العظيم في المجتمع .
ومن مقارنة ما جاء من التفسير في هاتين الروايتين مع ما ذكره المفسّرون من دلالة لفظ الماعون في الآية الكريمة ، يظهر استيلاء كلام المعصوم عليه السلام على كلام غيره ، وذلك يحثّ المشتغل في التفسير على تتبّع الروايات التي تناثرت في كتاب الكافي ، دون الاقتصار على المصادر التفسيرية التي يكون بعض التفسير فيها تطويل بلا طائل ، بعدما ورد عن أهل بيت العصمة صلوات اللّه عليهم من التفسير ، فهم مكلّفون بالبيان ، إذ نصّبهم اللّه تعالى أعلاما لدينه ، فكأنّ لسان حال تفسيراتهم يخاطب من اتّبع السبل التي لا تغني عن الحقّ شيئاً ، حاكيةً ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، إذ يقول :
أين تتيهون ، ومن أين تؤتون ، وأنّى تؤفكون ، وعلام تعمهون ، وبينكم عترة نبيّكم ، وهم أزمّة الصدق ، وألسنة الحقّ(1) .
ما رواه الكليني من سؤال أبي بصير للإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»(2) ، حيث بيّن الإمام أبو عبد اللّه الصادق عليه السلام حال الفقير والمسكين ، قائلاً:
الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم(3) .
وكأنّ تفسير الإمام عليه السلام انصبّ على بيان شدّة الحاجة وضعفها بين الفقير والمسكين ، وأردفه ببيان أشدّهما حاجةً ، متضمّنا التفريق بين الفقير والمسكين ،
ص: 419
وعليه تكون أصناف مستحقّي الزكاة ثمانية .
ثمّ يُفاد أمر آخر من تفسير الإمام عليه السلام وبيانه ، ألا وهو إرداف البائس وإضافته إلى مجموع الفقراء والمساكين بقوله : «والبائس أجهدهم»، ولم يقل: «أجهد منهما» ، وعلى ذلك فإنّ البأس ضابطة إضافية وأمر زائد على الفقر والمسكنة بعد أن أبان أنّ المسكين أجهد من الفقير ، فإنّ الفقير والمسكين يشتركان في عدم المال، بيد أنّ المسكين أجهد من الفقير .
ولكن بلحاظ انضمام النازلة أو البلية أو الزمانة ، كمن كان ذا عاهة في بدنه أو احترقت داره أو مات ولده مع ما عليه من الفقر أو المسكنة ، فهو أجهد الصنفين ، لا صنف ثالث .
وهذا التفسير للبائس أشار إليه المفسّرون(1) في قوله تعالى : «وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ»(2) ، إلاّ أنّهم لم ينبّهوا عليه في الآية محلّ البحث ، فلم يفيدوا من وحدة الموضوع في الآيتين - وهو التصدّق والمستحقّ - ما بيّنه المعصوم عليه السلام ، فيما رواه الكليني عنه في كتاب الزكاة .
وهذا الأمر - أي تتبّع ما روي عن الأئمّة عليهم السلام في الكتب الروائية ، وعلى رأسها كتاب الكافي - هو أسّ هذا البحث المتواضع .
فعلى كثرة ما تناول أهل التفسير من معنى الفقير والمسكين والتفريق بينهما أو اتّحادهما في الدلالة(3) ، وما حكوه عن أهل اللغة(4) ، لم يضمّوا الدلالة لمعنى الفقير
ص: 420
والمسكين في آية الزكاة من سورة التوبة مع دلالة الفقير في آية الهدي من سورة الحجّ ، وإنّما ذكروها كلاًّ على انفراد ، حيث ذكروا في معنى الفقير في الآية الأولى أقوالاً أوصلوها إلى تسعة(1) ، بين من يقول بشدّة حاجة الفقير ، وبين من يقول بعكسه ، وبين من يقول باتّحادهما ، بيد أنّهم ذكروا في معنى البائس في الآية الأُخرى أقوالاً عدّة أيضا .
ولا شكّ أنّ القرآن يفسّر بعضه، ويبيّن بعضه بعضاً ، ويشهد بعضه لبعض ، يهدف بذلك إلى الهداية والتعليم(2) ، ولكن قد يخفى تفسيره على غير عالمه الأكمل الذي قد خصّه اللّه تعالى ببيانه ، روى أحمد بن حنبل عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله قوله :
إنّ القرآن لم ينزل يكذّب بعضه بعضا ، بل يصدّق بعضه بعضا ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردّوه إلى عالمه(3) .
فمن هذا الوادي ما اتّضح من تقصّي إمام الكلام - وهو كلام الإمام عليه السلام
- في شذرة من تفسير هذه الآية ، فقد تضمّنت هذه الرواية التي رواها الكليني بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه الصادق صلوات اللّه عليه نكتة تفسيرية يجدها المشتغل بالتفسير بعد التتبّع والتأمّل ، ليقف على ما جلاه معدن العلم وخازن الوحي بعد آبائه الطيّبين ، الصادق القول البارّ الأمين .
ما رواه الكليني بسنده عن محمّد بن مسلم أنّه قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِى يَوْمَ
ص: 421
الْقِيَامَةِ»(1) . . . يعني ما بخلوا به من الزكاة(2) .
وقد ذكر المفسّرون في معنى «مَا بَخِلُواْ بِهِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قولين :
1 - البخل بمال الزكاة ومنعها(3) .
2 - بخل أهل الكتاب بما عندهم من خبر النبيّ صلى الله عليه و آله وصفته(4) .
قال ابن عطية :
والأحاديث في مثل هذا من منع الزكاة واكتناز المال كثيرة صحيحة(5) .
وروى هذه الأحاديث أرباب المجامع الحديثية بطرق عديدة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ، فمنها ما رواه الشافعي بسنده عن ابن مسعود(6) ، وبسنده عن أبي هريرة(7) ، وما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبي هريرة(8) ، وبسنده عن ابن عمر(9) ، وما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة(10) ، وما رواه مسلم بسندٍ عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري(11) ، وأيّد الثعلبي تفسيره «مَا بَخِلُواْ بِهِى» في الآية الكريمة بالزكاة ، بقوله :
ويدلّ عليه ما روى أبو وائل عن عبد اللّه، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، قال : ما من رجل لا يؤدّي زكاة ماله، إلاّ جُعل له شجاع في عنقه يوم القيامة، ثمّ قرأ علينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله مصداق
ص: 422
من كتاب اللّه تعالى: «سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (1) .
وأشار البيهقي إلى هذا التفسير في كتاب الزكاة بعد أن ذكر قوله تعالى : «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»(2) ، وقوله تعالى :
«سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(3) ، قائلاً : «فأبان اللّه في هاتين الآيتين فرض الزكاة؛ لأنّه إنّما عاقب على منع ما أوجب»(4) ، وأردفه بما يؤيّده من الأحاديث التي وردت عن النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله .
فهذا التفسير الذي جاء في رواية الكليني عن المعصوم عليه السلام ، مال إليه كثير من المفسّرين مؤيَّدا بما رووه عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ، كما يرشد إلى ذلك ما جاء من سبب نزول الآية ، قال الطبرسي : «والآية نزلت في مانعي الزكاة ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام ، وهو قول ابن مسعود وابن عبّاس والسدّي والشعبي وغيرهم»(5) .
وتفسير المعصوم وإن جاء على وفق تفسير غيره ، فالمتبّع ما ورد عن المعصوم، ففيه إصابة المراد بالخطاب ، والأجر على الاتّباع ، فلا بد للمشتغل بالتفسير من تتبّع ما تناثر من تفسير المعصومين في مثل كتاب الكافي ، فإنّ فيها من التفسير ما لا يمكن التغاضي عنه ، فإنّ الأئمّة المعصومين عليهم السلام شجرة العلم ، وأهل بيت النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفي دارهم مهبط جبرئيل ، وهم خزّان علم اللّه ، ومعادن وحي اللّه ، من تبعهم نجا ، ومن تخلّف عنهم هلك(6) ، فقد حباهم اللّه تعالى بعلم جدّهم النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وفهمه؛ ليقوموا مقامه من بعده(7) .
ص: 423
ما رواه الكليني بسنده عن أبي بصير، قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ»(1) . . .(2) .
قد تستدعي مناسبة بيان حكم معيّن بيان أحد مصاديق المعنى في الآية أو أحد أفراد معانيها من باب التطبيق ، خصوصا إذا كان الفرد المذكور هو الفرد الأظهر ، وقد يبقى الباب مفتوحا أمام إمعان النظر وحركة الفكر في الآية وغيرها من الآيات ؛ لإمكان إفادة دلالات أُخرى ، وقد أطلق السيّد محمّد حسين الطباطبائي - تبعا لما ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام - مصطلح الجري والتطبيق(3) ، وهو نظرية «يُراد بها أنّ الآية القرآنية أو أيّ جزءٍ منها ممّا يجري على قواعده العامّة في التفسير ، وهذا يعني أنّ التفسير في ظواهره يستوعب المعاني الأوّليّة لغةً وروايةً ، ولكن هناك بعض المعاني الثانوية الأساسية لاستنباط التفسير يكون إيرادها من قبيل تطبيق المفهوم على المصداق ، أو تطبيق المفاهيم العامّة على أبرز مصاديقها الخاصّة»(4) .
وذلك أنّ النصّ القرآني يحتمل وجوها ، ويكون تفسيرها بفردٍ معيّن من باب الجري والتطبيق، كانطباق الكلّي على مصاديقه ، أو الطبيعي على أفراده ، فيفسّر بأظهر أفراده للمناسبة أو القرينة ، وقد يركّز على مصداقها المثالي الذي هو أكمل المصاديق ، فإنّ القرآن كما قال عنه الإمام أبو جعفر محمّد الباقر عليه السلام : «حيّ لا يموت، والآية حيّة لا تموت . . .»(5) .
وفي هذه الآية كان الفرد الأظهر الذي يتعلّق به الإنسان ممّا تركه هو المال ، ولمّا كان أكمل الأفراد التي تتعلّق بالمال من العمل الصالح هو الزكاة ، كان التفسير بها
ص: 424
أولى من غيرها ، وإن كان يصدق على غيرها ، يضاف إلى ذلك أنّ الإمام في مقام بيان عظم أمر منع الزكاة .
وقد ذكر المفسّرون في تفسير «فِيمَا تَرَكْتُ» وجوها تحتملها الآية ، وعلّق بعضهم على التفسير بالمال بأنّه أولى ، إذ إنّه أوّل ما يُلحظ من الحقوق المتعلّقة بالمال ، قال ابن جزي :
قيل: يعني فيما تركت من المال ، وقيل: فيما تركت من الإيمان، فهو كقوله: «أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَانِهَا خَيْرًا»(1) ، والمعنى أنّ الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صالحاً في الإيمان الذي تركه أوّل مرّة(2) .
إلاّ أنّ أغلب مفسّري الجمهور الآخرين ، وإن ذكروا احتمال المال ، إلاّ أنّهم لم يشيروا إلى الزكاة ، متغافلين وحدة الموضوع مع ما في قوله تعالى : «وَ أَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِى إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ»(3) ، حيث فسّروه بأنّ مانع الزكاة إذا جاء الموت، أي حضر وعاينه، فحينئذٍ يسأل الرجعة إلى الدنيا(4) ، مستدلّين بقول ابن عبّاس ، قال :
قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من كان عنده ما يحجّ فلم يحجّ، أو ما يزكّه فلم يزكّه، سأل الرجعة عند الموت. فقال له رجل: اتّق اللّه يابن عبّاس، إنّما يسأل الرجعة الكافر، فقال: أنا أقرأ عليك قرآناً . . . : «مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِى إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ» . . .(5) .
ص: 425
وانفرد الآلوسي - فيما بين أيدينا من كتب التفسير عند الجمهور - بالإشارة إلى الزكاة في تفسير قوله تعالى : «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ»(1) ، وقرن إليها الحجّ بتفسير رفعه إلى ابن عبّاس ، بقوله :
. . . فعن ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما: إنّ مانع الزكاة وتارك الحجّ المستطيع يسألان الرجعة عند الموت(2) .
ثمّ اختار القول بأنّ المراد من : «فِيمَا تَرَكْتُ» التركة، وأيّده بما رواه جابر بن عبد اللّه الأنصاري عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله ، بقوله :
قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا حضر الإنسان الوفاة، يُجمع له كلّ شيء يمنعه عن الحقّ فيُجعل بين عينيه، فعند ذلك يقول : «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ» . . .(3) ، ثمّ قال بعد ذلك : وهذا الخبر يؤيّد أنّ المراد ممّا تركت من المال ونحوه(4) .
ويلفت البحث إلى جهتين :
1 - إنّ دلالة المتروك في قوله تعالى : «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ»(5) ، تنطبق على ترك زكاة المال بالدلالة التضمّنية ، وهو أظهر المصاديق ، بيد أنّه لا مانع من انطباقه على غيره من العبادات المالية والبدنية ، ممّا يتمنّى المرء أن يرجع إلى الدنيا من أجل امتثاله، ليتخلّص ممّا يراه حين ينكشف عنه الغطاء ويرى هول المطّلع ، أو حين يرى العذاب .
2 - ضرورة الجمع بين دلالات النصوص القرآنية ، ببركة تفسير المعصومين عليهم السلام .
وهاتان الجهتان يفادان من متابعة مثل ما رواه الكليني في الكافي ، فجزاه اللّه عن الإسلام والمسلمين خير جزاء المحسنين .
ص: 426
1 - الكليني : هو أبو جعفر محمّد بن يعقوب
بن إسحاق الكليني الرازي البغدادي ، شيخ جليل فقيه عارف بالأخبار ثقة ، توفّي ببغداد سنة (329 ه ) .
2 - كتاب الكافي من المجامع الحديثية المهمّة التي انتظمت الكثير من درر أقوال المعصومين عليهم السلام ، في شتّى العلوم الدينية ، ومنها التفسير .
3 - انتظم الكافي عدداً كبيراً من الروايات المعتبرة .
4 - تناثرت روايات تفسيرية كثيرة في كتاب الكافي ، وضعها الكليني بحسب النهج الذي اتّبعه في ترتيب الكتب والأبواب .
5 - تمخّضت بعض الروايات للتفسير ، حيث يُسئل الإمام عن تفسير آية ، بيد أنّها أفادت أمراً أو حكما آخر ، ممّا جعلها لائقة في بابها .
6 - جاءت بعض الروايات لبيان حكم فقهي ، إلاّ أنّها انتظمت بيانا تفسيريا ، أو جعلها الإمام شاهدا على الحكم ، ليستفيد منها الفقيه استنباط ذلك الحكم ، أو أنّها تدعم الاستدلال عليه .
7 - احتوى كتاب الزكاة جملة من روايات اعتنت بعضها بالتفسير أوّلاً وبالذات ، ومنها اعتنت به ثانياً وبالعرض .
8 - تنوّعت البيانات التفسيرية في روايات كتاب الزكاة - كأُنموذج - .
9 - لا بدّ للمفسّر من النظر إلى الكتب الروائية، خصوصا مثل ما اشتمله الكافي من
الروايات عن المعصومين عليهم السلامالذين هم أعلام الهدى وسفينة النجاة ، وهم عيبة علم اللّه القائمون على أمره وبيان كتابه .
10 - اتّسمت بعض الموارد التفسيرية بما يصطلح عليه «الجري والتطبيق» .
ص: 427
1 . القرآن الكريم .
2 . الاعتقادات وتصحيح الاعتقادات ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه ) ، تحقيق : حسين درگاهي ، بيروت : منشورات دار المفيد للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، 1414 ه .
3 . الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ، علي بن هبة اللّه العجلي الجُرباذقاني (ابن ماكولا) (ت 475 ه ) ، القاهرة : منشورات دار الكتاب الإسلامي الفاروق الحديثة .
4 . الأُمّ ، أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس الشافعي (ت 204 ه ) ، بيروت : دار الكتب العلمية .
5 . الأمالي ، محمّد بن على بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (ت 381 ه ) ، تحقيق : مؤسّسة البعثة ، قمّ : مؤسّسة البعثة ، الطبعة الأولى ، 1407 ه .
6 . أحكام القرآن ، أبو بكر محمّد بن عبد اللّه
بن محمّد بن عبد اللّه بن عربي (ت 543 ه ) ، تحقيق : محمّد عبد القادر عطا، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر .
7 . أحكام القرآن ، أحمد بن علي الجصّاص الرازي (ت 370 ه ) ، تحقيق : عبد السلام محمّد علي شاهين ، بيروت : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1415 ه .
8 . أعيان الشيعة ، محسن بن عبد الكريم الأمين الحسينيّ العامليّ الشقرائيّ (ت 1371 ه ) ، تحقيق : السيّد حسن الأمين ، بيروت : دار التعارف ، الطبعة الخامسة ، 1403 ه .
9 . البحث الروائي في تفسير الميزان ، مظاهر جاسم عبد الكاظم ، رسالة ماجستير - كلّية الفقه ، جامعة الكوفة ، 2006 م .
ص: 428
10 . البحر المحيط ، محمّد بن يوسف الغرناطى (ت 745 ه ) ، طبعة الرياض ، المملكة العربية السعودية .
11 . البرهان ، محمّد بن عبد اللّه الزركشي (ت 794 ه ) ، تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة : منشورات دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، الطبعة الأولى ، 1376 ه .
12 . التسهيل لعلوم التنزيل ، أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد الغرناطي الكلبي المعروف بابن جزي
( ت 741 ه ) ، لبنان : دار الكتاب العربي ، 1403 ه .
13 . تفسير ابن زمنين ، أبو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه بن أبي زمنين (ت 399 ه ) ، تحقيق : أبو عبد اللّه حسين بن عكاشة ، القاهرة : مطبعة الفاروق الحديثة ، الطبعة الأولى ، 1423 ه .
14 . تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي
الدمشقي (ت 774 ه ) ، تحقيق : مكتب التحقيق بدار المعرفة ، بيروت : منشورات دار المعرفة ، 1412 ه .
15 . تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم) ، أبو السعود محمّد بن محمّد العمادي (ت 951 ه ) ، بيروت : دار إحياء التراث العربي .
16 . تفسير البغوي ، أبو محمّد الحسين بن مسعود
بن محمّد البغوي (ت 510 ه ) ، تحقيق : خالد عبد الرحمن العك ، بيروت : دار المعرفة .
17 . تفسير البيضاوي ، عبد اللّه بن عمر بن محمّد الشيرازي البيضاوي (ت 791 ه ) ، بيروت : منشورات محمّد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1424 ه .
18 . تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) ، عبد الرحمن بن محمّد بن مخلوف أبو
زيد المالكي المعروف بالثعالبي (ت 875 ه ) ، تحقيق : علي محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود وعبد الفتّاح أبو سنة ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، مؤسّسة التاريخ العربي ، 1418 ه .
19 . تفسير الثعلبي (الكشف والبيان في تفسير القرآن) ، أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي
ص: 429
(ت 427 ه ) ، تحقيق : أبو محمّد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق : نظير الساعدي ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى ، 1422 ه .
20 . تفسير السمعاني ، أبو المظفّر منصور بن محمّد (ت 489 ه ) ، تحقيق : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عبّاس بن غنيم ، الرياض : دار الوطن ، الطبعة الأولى ، 1418 ه .
21 . تفسير الطبريّ (جامع البيان في تفسير القرآن) ، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ (310 ه )، تحقيق : صدقي جميل العطّار ، بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1415 ه .
22 . تفسير العيّاشي ، أبو النضر محمّد بن مسعود السلمي السمرقندي المعروف بالعيّاشي (ت 320 ه )، تحقيق : محمود مطرجي بيروت : دار الفكر .
23 . تفسير العيّاشي ، أبو النضر محمّد بن مسعود السلمي السمرقندي المعروف بالعيّاشي (ت 320 ه )، تحقيق : السيّد هاشم الرسولي المحلاّتي ، طهران : المكتبة العلميّة ، الطبعة الأولى ، 1380 ه .
24 . تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ، أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيّ (ت 671 ه ) ، تحقيق : محمّد عبد الرحمن المرعشلي ، بيروت : دار إحياء التراث العربيّ ، الطبعة الثانية ، 1405 ه .
25 . تفسير القمّي ، عليّ بن إبراهيم القمّي ، قمّ : منشورات مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر ، الطبعة الثالثة ، 1404 ه .
26 . التفسير الكبير ومفاتيح الغيب (تفسير الفخر الرازي) ، أبو عبد اللّه محمّد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي (ت 604 ه ) ، بيروت : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1421 ه .
27 . تفسير مجاهد ، مجاهد بن جبر التابعي المكّي مولى بني مخزوم (ت 104 ه ) ، تحقيق :
عبد الرحمن الطاهر بن محمّد السورتي ، إسلام آباد : منشورات مجمع البحوث الإسلامية .
28 . تفسير مقاتل ، مقاتل بن سليمان (ت 150 ه ) ، تحقيق : أحمد فريد ، بيروت : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1424 ه .
ص: 430
29 . جامع الأُصول في أحاديث الرسول ، أبو السعادات مجد الدين المبارك
بن محمّد المعروف بابن الأثير الجزريّ (ت 606 ه ) ، القاهرة : مطبعة السنّة المحمّدية ، الطبعة الأولى ،
1374 ه .
30 . رجال الطوسي ، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسيّ (ت 460 ه ) ، تحقيق : جواد القيّوميّ ، قمّ : مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ، الطبعة
الأولى ، 1415 ه .
31 . رجال النجاشيّ (فهرس أسماء مصنّفي الشيعة) ، أبو العبّاس أحمد بن عليّ النجاشيّ (ت 450 ه ) ، قمّ : منشورات مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين .
32 . روح المعاني في تفسير القرآن (تفسير الآلوسي) ، محمود بن عبد اللّه الآلوسي (ت 1270 ه ) ، بيروت : دار إحياء التراث العربي .
33 . روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، محمّد باقر الخوانسارى ، الطبعة الحجرية ، 1352 ه .
34 . زاد المسير في علم التفسير ، عبد الرحمن بن علي القرشي البغدادي المعروف بابن الجوزي (ت 597 ه ) ، تحقيق : محمّد عبد اللّه ، بيروت : دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 1407 ه .
35 . سنن الترمذي (الجامع الصحيح) ، أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279 ه ) ، طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول ، بيروت : منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1401 ه .
36 . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت 398 ه ) ، تحقيق : أحمد بن عبد الغفور عطّار ، بيروت : دار العلم للملايين ، الطبعة الرابعة ، 1410 ه .
37 . صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري (ت 261 ه ) ، بيروت : منشورات دار الفكر .
38 . عيون الحكم والمواعظ ، أبو الحسن عليّ بن محمّد الليثي الواسطي (قرن 6 ه ) ، تحقيق : حسين الحسني البيرجندي ، قمّ : دار الحديث ، الطبعة الأولى ، 1376 ه .
ص: 431
39 . فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير ، محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني (ت 1255 ه ) .
40 . الكافي ، أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329 ه ) ، بيروت : منشورات الفجر ، الطبعة الأولى ، 1428 ه .
41 . كشف المحجّة لثمرة المهجة ، أبو القاسم رضيّ الدين عليّ بن موسى بن طاووس الحسني (ت 664 ه )، تحقيق: محمّد الحسّون ، قمّ : مكتب الإعلام الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1412 ه .
42 . كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشر ، أبو القاسم علي بن محمّد بن علي الخزّاز القمّي (ق 4 ه ) ، تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري ، نشر : بيدار ، الطبعة الأولى ، 1401 ه .
43 . كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال ، علي المتّقي بن حسام الدين الهندي (ت 975 ه ) ، تحقيق : صفوة السقا وبكري حياني ، بيروت : مؤسّسة الرسالة ، 1409 ه .
44 . لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور المصري (ت 711 ه ) ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، منشورات : مؤسّسة أدب الحوزة ، 1405 ه .
45 . لسان الميزان ، أبو الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني (ت 852 ه ) ، بيروت : مؤسّسة الأعلمي ، الطبعة الثالثة ، 1406 ه .
46 . مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو عليّ الفضل بن الحسن الطبرسيّ (ت 548 ه ) ، تحقيق : لجنة من العلماء والمحقّقين ، بيروت : مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ، الطبعة الأولى ، 1415 ه .
47 . المحرّر الوجيز ، ابن عطية الأُندلسي ، (ت 546 ه ) ، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمّد ، بيروت : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1413 ه .
48 . مسند أحمد ، أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني (ت 241 ه ) ، تحقيق : عبد اللّه محمّد الدرويش ، بيروت : دار الفكر ، الطبعة الثانية ، 1414 ه .
ص: 432
49 . المصنّف ، أبو بكر عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني (ت 211 ه ) ، تحقيق : مصطفى مسلم محمّد ، الرياض : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى .
50 . معاني القرآن ، أبو جعفر أحمد بن محمّد المرادي (ابن النحّاس) (ت 338 ه ) ، تحقيق : محمّد علي الصابوني ، مكّة : جامعة أُمّ القرى ، الطبعة الأولى ، 1408 ه .
51 . معجم الفروق اللغويّة ، أبو هلال الحسن بن عبد اللّه بن سهل العسكري (ت 400 ه ) ، تحقيق : مؤسّسة النشر الإسلامي ، قمّ : مؤسّسة النشر الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1412 ه .
52 . المعجم الكبير ، أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (ت 360 ه ) ، تحقيق :
حمدي عبد المجيد السلفي ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية ، 1404 ه .
53 . معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس الرازي القزويني (ت 395 ه ) ، تحقيق عبد السلام محمّد هارون ، القاهرة : منشورات دار إحياء الكتاب العربي ، عيسى البابي حلبي وشركاؤه ، الطبعة الأولى ، 1366 ه .
54 . معرفة السنن والآثار ، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه ) ، تحقيق : سيّد كسروي حسن ، بيروت : دار الكتب العلمية .
55 . منزلة كتاب الكافي عند الشيعة ، إبراهيم محمّد جواد .
ptth://mth.61/keerat-nm-keakh/moc.mosam41.www
56 . الميزان في تفسير القرآن ، محمّد حسين الطباطبائي (ت 1402 ه ) ، قمّ : منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية .
57 . يسير الكريم الرحمن في كلام المنّان ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376 ه ) ، تحقيق : ابن عثيمين ، بيروت : مؤسّسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، 1421 ه .
ص: 433
ص: 434
إشارات إلى تفسير الإمام الصادق عليه السلام
في أُصول الكافي قراءة تحليلية موازنة
د . حميد الفتلي(1)
إلى حضرة صاحب العصر والزمان (عج)
أهدي هذا العمل، فإنّه من بقيّة علوم آبائه عليهم السلام، وأهدي هذا الجهد أيضا إلى أحد أوعية علومهم الشيخ الكليني (رضوان اللّه تعالى عليه) .
بسم اللّه الرحمن الرحيم ، الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، قيّماً لينذر بأسا شديدا من لدنه ، وبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنّ لهم أجرا حسنا ، والصلاة والسلام على أشرف خلق اللّه محمّد القائل :
إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبدا : كتاب اللّه، وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض .
وبعد ، فإنّ القرآن كلام اللّه المنزل، والنور الذي أودعه نبيّه وأهل بيته الأطهار ، وإنّ في القرآن المحكم والمتشابه ، وإنّ له ظاهرا وباطنا ، ولا يعلم تفسيره وتأويله إلاّ اللّه
ص: 435
ومن خصّ من عباده؛ محمّد وأهل بيته المعصومين، مصداقا لقوله تعالى : «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُو إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّ سِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِى كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا» . فالراسخون في العلم هم أهل بيت النبوّة كما فسّره أبو عبد اللّه الصادق عليه السلام .
وإنّ هذا البحث محاولة يسيرة لالتقاط بعض اللآلئ من ذلك البحر الزاخر بالعلم والمعرفة، ألا وهو قراءة ما نطق به الإمام الصادق من تفسير للقرآن الكريم، ونقله الشيخ الكليني في أُصول الكافي .
وكنت آمل أن أستوعب كلّ ما ورد عنه عليه السلام من تفسير في جميع الكافي، أُصوله وفروعه والروضة ، لكنّ عجالة مثال هذه لا تستوعب ذلك، فقصرت بحثي على الجزء الأوّل من الأُصول، وأسميته «إشارات إلى تفسير الإمام الصادق عليه السلام في أُصول الكافي، قراءة تحليلية موازنة» .
وجعلت السور بحسب ترتيبها في القرآن الكريم، مراعيا تسلسل الآيات داخل كلّ سورة، مبتعدا بذلك عن منهج الكافي .
وجاء هذا البحث منحصرا بين سورتي البقرة وطه المباركتين ، وهذا يكوّن أكثر من نصف القرآن ، علما بأنّ لنا إصدارا خاصّا بتفسير الإمام الصادق عليه السلام يرى النور قريبا إن شاء اللّه .
وكان منهجي توثيق الآية الكريمة التي أوردها الشيخ الكليني من القرآن الكريم ، ثمّ تثبيت رواية الإمام الصادق بنصّها، مكتفيا بآخر راوٍ يتّصل بالإمام طلبا للاختصار والإيجاز، فالتعليق عليها بشرحها وبيانها والإشارة إلى بعض المفسّرين الذين أخذوا بها ، وأحيانا أشير إلى غير الآخذين بها وعمل موازنة بين مفسّري الشيعة ومفسّري العامّة بما يتّصل بتفسيره عليه السلام ، وبيان رأيي إن أمكن ذلك .
وقد أفدت من أُمّهات كتب الحديث والرواية، كالتوحيد وكتاب مَن لا يحضره الفقيه وموسوعة أحاديث الشيعة وجامع الأحاديث والبحار ، وأفدت كثيرا من شرح أُصول الكافي، وتفاسير الشيعة، كالتبيان ومجمع البيان والميزان، وأشرت إلى بعض تفاسير العامّة،
ص: 436
كتفسير الرازي والقرطبي وسواهما .
أخيرا، اللّه أسأل أن يكون هذا البحث المتواضع قربانا لوجهه الكريم ، وحبلاً يوصلني إليه بالتمسّك بأوليائه المعصومين، فقد قال : «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ»، وأنّهم هم الحبل الموصل إلى رضاه .
ربّنا تقبّل هذا اليسير، واعفُ عن الكثير، إنّك نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أنّ الحمد للّه ربّ العالمين .
1 - قال تعالى : «يَا بَنِى إِسْرٰ ءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِىَ الَّتِى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّاىَ فَارْهَبُونِ»(1) .
ذكر الكليني في باب «نكت ونتف من التنزيل في الولاية» تفسير الإمام لهذه الآية بسندٍ متّصل عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في قوله جلّ وعزّ : «وَ أَوْفُواْ بِعَهْدِى» : «بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ، «أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» : أوفِ لكم الجنّة(2)» .
فالعهد في الآية الكريمة يعني ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ، وهو الأمر الذي كان يؤكّد عليه الأئمّة عليهم السلام في كلّ مناسبة، «والولاية داخلة في العهد؛ لأنّها بعض أفراده وأكملها، فهي أولى بالإرادة منه، ثمّ إنّه أخذ العهد عليهم بالولاية في التوراة ، حيث ذكرها فيه كما ذكر الرسالة ، أو في الذرّ على احتمالٍ بعيد»(3) . وقد أكّد هذا التأويل الأئمّة عليهم السلام(4) .
وفسّر كثير العهد بأنّه اتّباع محمّد صلى الله عليه و آله ، وهو معنىً لا يبعد عن المعنى الذي قرّره الإمام الصادق عليه السلام ، فإنّ ولاية الإمام عليّ عليه السلام إنّما هي طريق لولايته صلى الله عليه و آله (5) .
ص: 437
في حين فسّر آخرون العهد تفسيرا ظاهريا، فإنّ ذلك عامّ في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه، فيدخل في ذلك ذكر محمّد صلى الله عليه و آله في التوراة(1) . وتفسير الإمام هو الأشمل والأوضح والأولى .
2 - قال تعالى : «الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُو حَقَّ تِلاَوَتِهِى أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ»(2) .
نقل الكليني رحمه الله في باب «من اصطفاه اللّه من عباده وأورثهم كتابه» بسندٍ عن أبي ولاّد، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُو حَقَّ تِلاَوَتِهِى أُوْلٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ» ؟ قال : هم الأئمّة عليهم السلام(3) .
إنّ حق تلاوة القرآن حفظ معانيه الظاهرة والباطنة وضبط جواهر كلماته وحروفه وكيفياته، وهذا كلّه ليس إلاّ في وسع الأئمّة عليهم السلام؛ إذ لا يعلم غيرهم معاني القرآن كلّها، باتّفاق الأُمّة(4) .
وقد نقل هذه الرواية أيضا طائفة من المفسّرين(5) .
في حين أثبتت طائفة أُخرى أقوالاً بعيدة عن هذا المعنى، فذكروا أنّ معنى «الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ» هم «أصحاب النبيّ محمّد صلى الله عليه و آله ، الذين آمنوا بالقرآن وصدقوا به»(6) . وسكت كثير منهم عن التصريح بهم(7) .
وذكر جماعة أنّ هذه الآية نزلت في الذين آمنوا من اليهود(8) . وللمتدبّر أن يختار
ص: 438
من هذه الأقوال ما يراه، فإنّ الشمس لا يحجبها الغربال .
3 - قال تعالى : «وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ»(1) .
نقل الكليني في باب «إنّ الأئمّة شهداء اللّه عزّ وجلّ على خلقه»، بسندٍ عن بُريد العجلي، أنّه قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ» ؟ قال : نحن الأُمّة الوسطى، ونحن شهداء اللّه على خلقه وحججه في أرضه ، قلت : قول اللّه عزّ وجلّ : «مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» ؟ قال : إيّانا عنى خاصّة «هُوَ سَمَّائُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ»، في الكتب التي مضت وفي هذا القرآن : «وَ جَاهِدُواْ فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَ هِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَ فِى هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَ اعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ»(2)، فرسول اللّه صلى الله عليه و آله الشهيد علينا بما بلّغنا عن اللّه عزّ وجلّ، ونحن الشهداء على الناس، فمن صدّق صدّقناه يوم القيامة، ومن كذّب كذّبناه يوم القيامة(3) .
و «الأُمّة الوسط»، أي أشرف الأُمم وأفضلهم، وخيارهم وأعدلهم(4) .
وقد أثبتت تفاسير الشيعة هذه الرواية بشيء من الشرح والتفصيل، وأحيانا بطرق أُخرى لها ، فقد جاء في تفسير العيّاشي عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
«لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ»، قال : «بما عندنا من الحلال والحرام، وبما ضيّعوا منه» .
وعن أبي عمرو الزبيدي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
قال : «وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ»، فإن ظننت أنّ
ص: 439
اللّه عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحّدين أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاعٍ من تمر يطلب اللّه شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأُمم الماضية ! كلاّ لم يعن اللّه مثل هذا من خلقه ، يعني الأُمّة التي وجبت لها دعوة إبراهيم: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» ، وهم الأُمّة الوسطى، وهم خير أُمّة أُخرجت للناس(1) .
في حين ذكر الطبرسي معنيين لقوله تعالى : «أُمَّةً وَسَطًا»، أحدهما :
إنّه أخبر عزّ اسمه أنّه جعل أُمّة نبيّه محمّد صلى الله عليه و آله عدلاً وواسطة بين الرسول والناس(2) .
وهذا مذهب كثير من المفسّرين ممّن لم يطلعوا على رواية الإمام أو يأخذوا بها .
وثانيهما : «إنّ الأُمّة الوسط هم الأئمّة عليهم السلام، وقد نقل هذا المعنى مرفوعا إلى الإمام عليّ والباقر عليهماالسلام، وهو ما نحن فيه»(3) . وأخذ بهذا الرأي كثير من مفسّري الشيعة(4) .
وقد أفاد صاحب الميزان في تفسيره لهذه الآية من الرواية التي نحن فيها، وإن لم ينقل نصّها، قال :
ومن المعلوم أنّ هذه الكرامة ليست تنالها جميع الأُمّة ، إذ ليست إلاّ كرامة خاصّة للأولياء الطاهرين منهم ، وأمّا من دونهم من المتوسّطين في السعادة والعدول من أهل الإيمان، فليس لهم ذلك، فضلاً عن الأجلاف الجافية ، والفراعنة الطاغية من الأُمّة(5) .
فالشيعة بين آخذٍ بالرواية، وبين مفيدٍ منها .
في حين فسّرها جماعة تفسيرا لغويا ليس فيه دلالات إضافية ، قالوا :
كما أنّ الكعبة وسط الأرض، كذلك جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأُمم، والوسط
ص: 440
العدل، لتكونوا شهداء على الناس؛ أي في المحشر للأنبياء على أُممهم(1) .
تدفعهم بذلك دوافع عقائدية، أو ربما أنّهم لم يوفقوا في الوصول إلى هذه الرواية، واللّه أعلم .
4 - قال تعالى : «اللَّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»(2) .
ذكر الكليني في باب «فيمن دانَ اللّه عزّ وجلّ بغير إمام من اللّه جلّ جلاله»، تفسير الظلمات والنور، قال :
قال الإمام الصادق عليه السلام برواية عبد اللّه بن أبي يعفور ، في تفسير قوله تعالى : «اللَّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» : يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة، لولايتهم كلّ إمام عادل من اللّه . وقال : «وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ» ، إنّما عنى بهذا أنّهم كانوا على نور الإسلام، فلمّا أن تولّوا كلّ إمامٍ جائر ليس من اللّه عزّ وجلّ بولايتهم إيّاه، أخرجهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر، فأوجب اللّه لهم النار مع الكفّار، ف «أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (3) .
وقد أثبت العيّاشي هذه الرواية وقال : «إنّ النور هم آل محمّد صلى الله عليه و آله ، والظلمات عدوّهم»(4) .
وأخذ جملة من المفسّرين من أصحابنا وغيرهم بهذا المعنى(5) .
ص: 441
5 - قال تعالى : «وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا»(1) .
روى الكليني في باب «معرفة الإمام والردّ إليه»، بسندٍ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في قوله عزّ وجلّ : «وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا»، قال : «طاعة اللّه ومعرفة الإمام»(2) .
فقد فسّر الإمام عليه السلام الحكمة بطاعة اللّه ومعرفة الإمام . قال المازندراني في شرح أُصول الكافي شارحا قوله عليه السلام الذي أثبتناه :
قوله: طاعة اللّه ومعرفة الإمام، إنّما نسب المعرفة إلى الإمام ، والطاعة إلى اللّه؛ لأنّ معرفة الإمام مستلزمة لمعرفة اللّه، وطاعة اللّه مستلزمة لطاعة الإمام ، فيرجع الكلام إلى أنّ الحكمة طاعة اللّه وطاعة الإمام ومعرفتهما، فتكون المعرفة إشارة إلى الحكمة النظرية والطاعة إلى الحكمة العملية(3) .
وقد أخذ بعض المفسّرين بمعنى قوله تعالى ، قال القمّي :
قوله : «يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا»، قال : الخير الكثير معرفة أمير المؤمنين والأئمّة عليهم السلام(4) .
ونقل الطبرسي عنه عليه السلام أنّ معنى الحكمة هو القرآن والفقه ، ثمّ ذكر معاني كثيرة، كالقرآن والعلم والإصابة عن القول والفعل والنبوّة، ومعرفة اللّه وخشيته ، وكلّ هذه المعاني تدور في فلك المعنى الذي أثبته وقرّره عليه السلام (5) .
1 - قال تعالى : «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُو إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّ سِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِى كُلٌّ مِّنْ عِندِ
ص: 442
رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ»(1) .
نقل الكليني في باب «إنّ الراسخين في العلم هم الأئمّة عليهم السلام» ثلاث روايات عن الصادق عليه السلام تؤكّد هذا المعنى.
أحدها: بسندٍ متّصل إلى أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله» .
والثانية : عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام ، أنّه قال :
الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمّة من بعده عليهم السلام .
والثالثة : بسندٍ عن بريد بن معاوية، عن أحدهما عليهماالسلام، قال :
فرسول اللّه صلى الله عليه و آله أفضل الراسخين في العلم، وقد علّمه اللّه عزّ وجلّ جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان اللّه لينزل عليه شيئا لم يعلّمه تأويله ، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه ، والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلمٍ ، فأجابهم اللّه بقوله : «يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِى كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا»، والقرآن خاصّ وعامّ، ومحكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، فالراسخون في العلم يعلمونه(2) .
وقد أثبت العيّاشي وغيره هذه الرواية، وأخذوا بها(3) .
فالراسخون في العلم هم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام بنصّ الروايات الشريفة التي أثبتناها .
قال صاحب بيان السعادة مفسّرا :
والراسخون في العلم رسوخا قائما، وهم الذين بلغوا إلى مقام المشيّة، وارتقوا عن مقام الإمكان ، وهم محمّد صلى الله عليه و آله وأوصياؤه الاثنا عشر لا غيرهم ، وأمّا غيرهم من الأنبياء والأولياء، فلمّا لم يرتقوا عن مقام الإمكان، لم يعلموا تأويلها التامّ، بل بقدر
ص: 443
مقامهم وشأنهم . . .(1) .
في حين فسّر بعضهم الراسخين تفسيرا لغويا ظاهريا، فقيل : «الراسخون : الثابتون في العلم ، الضابطون له، المتقنون فيه»(2) .
2 - قال تعالى : «أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَ نَ اللَّهِ كَمَنم بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ»(3) .
روى الشيخ الكليني رحمه الله في باب «نكت ونتف من التنزيل في الولاية»، بسندٍ عن عمّار الساباطي، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَ نَ اللَّهِ كَمَنم بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ» ؟ فقال : الذين اتّبعوا رضوان اللّه، هم الأئمّة، وهم واللّه يا عمّار درجات للمؤمنين، وبولايتهم ومعرفتهم إيّانا يضاعف اللّه لهم أعمالهم ويرفع اللّه لهم الدرجات العُلى(4) .
وقال المازندراني شارحا قول الإمام «هم الأئمّة» :
الظاهر أنّ الضمير راجع إلى الذين أُتبعوا، ويحتمل أن يكون راجعا إلى رضوان اللّه، وإطلاقه على الأئمّة مجاز، من باب إطلاق المسبّب على السبب؛ لأنّهم سبب لرضوان اللّه تعالى . وقوله : "وهم واللّه يا عمّار درجات للمؤمنين"، الحمل للمبالغة ، أو التقدير ذوو درجات باعتبار تفاوت مقامات المؤمنين بهم بالنسبة إليهم في المحبّة والطاعة والعلم والعمل . وقوله : "يضاعف اللّه لهم أعمالهم" على حسب أحوالهم فيما ذكر، وكذلك قوله: "يرفع اللّه لهم الدرجات العلى" (5) .
وقد أثبت بعض المفسّرين هذه الرواية، وأضاف :
ص: 444
قوله عليه السلام : "... يا عمّار كمن باء بسخطٍ من اللّه . . ."، فهم واللّه الذين جحدوا حقّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، وحقّ الأئمّة منّا أهل البيت ، فباؤوا لذلك سخطا من اللّه (1) .
في حين فسّر غير واحدٍ الآية تفسيرات، منها: إنّه اتّبع رضوان اللّه في العمل بطاعته . ومنها: إنّه اتّبع رضوان اللّه في ترك الغلول . ومنها: إنّه اتّبع رضوان اللّه في الجهاد في سبيله(2) .
وهذه من التفسيرات التي تأخذ بظواهر الآيات .
وفسّر الواحدي قوله : «من اتّبع رضوان اللّه» بالمؤمنين، و «كمن باء بسخطٍ من اللّه» يعني المنافقين(3) .
وإنّما أثبتنا أقوال بقيّة المفسّرين في هذه الآية وفي غيرها؛ ليتبيّن الفرق بين ما روي عن الإمام عليه السلام ، وما نُقل عن غيره، فإنّ ذلك من باب ابتغاء الوصول إلى الحقيقة، وهي ظاهرة واضحة ، ومن باب إقامة الحجّة على من يسمع مقالتنا هذه، فقد روي عن الأئمّة عليهم السلام قالوا : «أحيوا أمرنا، رحم اللّه من أحيا أمرنا» .
1 - قال تعالى : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِى فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَ هِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا»(4) .
نقل الكليني في باب «إنّ الأئمّة عليهم السلام ولاة الأمر وأنّهم الناس المحسودون» تفسير قوله تعالى بسندٍ عن حمران بن أعين، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : قوله عزّ وجلّ : «فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَ هِيمَ الْكِتَابَ»؟ فقال : النبوّة ، قلت و «وَالْحِكْمَةَ» ؟ قال : الفهم والقضاء ، قلت : «وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا
ص: 445
عَظِيمًا» ؟ فقال : الطاعة .
وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الصبّاح، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ» ؟ فقال : يا أبا الصبّاح، نحن واللّه الناس المحسودون(1) .
ففسّر عليه السلام الكتاب بالنبوّة ، والحكمة بالفهم والقضاء ، والمُلك العظيم بالطاعة ، كما أنّه فسّر الناس في الآية الكريمة بالأئمّة عليهم السلام ، فإنّهم هم المحسودون حقّا . وقد أقسم الإمام كما في نصّ الرواية لتثبيت ذلك في نفس السائل ؛ لأنّ القسم ضرب من التوكيد درج عليه العرب، والإمام لا يخالف سنن العرب في كلامهم .
وإطلاق الكتاب على النبوّة باعتبار أنّه مستلزم لها ، أو باعتبار أنّه عبارة عن المكتوب، وإيتاء النبوّة كان مكتوبا في اللوح المحفوظ بقلم التقدير . وقوله : "قال : الفهم والقضاء"، يعني أنّ الحكمة عبارة عن العلم باللّه وأسرار التوحيد والقوانين الشرعية والقضاء بين الناس بالعدل، فهي عبارة عن الحكمة النظرية والعملية وبناء الخلافة عليهما . قوله : "فقال : الطاعة"، أي طاعة الخلق لهم في خصالهم وأفعالهم وأقوالهم وعقائدهم، وهي مُلك عظيم لا يوازيه شيء(2) .
وأكّد الإمام الرضا عليه السلام هذه الرواية وهو يفسّر قوله تعالى الذي ذكرناه، قال : «يعني الطاعة للمصطفين الطاهرين، والمُلك هنا الطاعة لهم»(3) .
وقد أخذ كثير من المفسّرين بهذه الرواية، فمنهم من أثبتها بألفاظها، كالعيّاشي والقمّي وغيرهما(4) ، ومنهم من نقل لهذه الآية تفسيرا قريبا لما روي عن الإمام، لكنّه
ص: 446
لم يشر إليها(1) .
في حين بَعُد بعض المفسّرين كثيرا ووسّع الدائرة، ففسّر «الناس» في قوله تعالى : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ...» أي النبيّ صلى الله عليه و آله خاصّة .
وقيل : «الناس» العرب .
وقيل : حسدت اليهود قريشا ؛ لأنّ النبوّة فيهم ، وفسّروا المُلك العظيم بأنّه ملك سليمان(2) .
وهذه تفسيرات ظاهرية تدفع إليها دوافع فكرية أو عقائدية ، والأولى الرجوع في هذا وفي غيره إلى الرواية ، فإنّه لا اجتهاد مع النصّ .
2 - قال تعالى : «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»(3) .
أثبت الكليني في باب «إنّ الإمام عليه السلام يعرف الإمام الذي يكون بعده» روايةً بسندٍ عن المعلّى بن خُنيس، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» ؟ قال : أمر اللّه الإمام الأوّل أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كلّ شيء عنده(4) .
وقال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام :
هذه الآية مخاطبة لنا خاصّة، أمر اللّه تبارك وتعالى كلّ إمام منّا يؤدّي إلى الإمام الذي بعده ويوصي إليه ، ثمّ هي جارية في سائر الأمانات(5) .
فالأمانة كما يُفهم من الرواية الشريفة العهد أو الإمامة، يؤدّيها كلّ إمام إلى الذي
ص: 447
يليه ، قال الإمام الرضا عليه السلام «ولا يخصّ بها غيره ولا يزويها عنه»(1) .
وقد نقل الشيخ الطوسي ثلاثة أقوال في الأمانة :
الأوّل : إنّ كلّ مؤتمن على شيء يلزمه ردّه .
الثاني : أمر اللّه الأئمّة كلّ واحد منهم أن يسلّم الأمر إلى من بعده، وهي الرواية التي نحن فيها .
الثالث : نزلت في عثمان بن طلحة، أمر اللّه تعالى نبيّه أن يردّ إليه مفاتيح الكعبة(2) .
في حين فسّرها غير واحد من مفسّري العامّة تفسيرا بعيدا، فيه كثير من السذاجة والبساطة ، قيل : إنّها نزلت في الأُمراء وأمرهم أن يؤدّوا الأمانة في أموال المسلمين، أو أنّها نزلت عامّة في الودائع وغيرها من الأمانات(3) .
فأمّا على القول الأوّل ، فإن كان المقصود به الأُمراء الدنيويّين أو الملوك وأمثالهم، فلم يحفظ لنا التاريخ منهم أحدا أدّى الأمانة إلى المسلمين، إلاّ أقلّهم ، فعلى هذا القول يكونون مخالفين لأمرٍ من أوامر اللّه . وأمّا على القول الثاني، فقد أشار إليه الأئمّة
شريطة أن يبدأ بهم عليهم السلام ثمّ يجري على ما سواهم .
3 - قال تعالى : «أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ»(4) .
نقل الكليني في باب «ما نصّ اللّه عزّ وجلّ ورسوله على الأئمّة عليهم السلامواحدا فواحدا»، بسندٍ عن أبي بصير، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ» ؟ قال : نزلت في عليّ
بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام، فقلت له: إنّ الناس يقولون : فما لم يسمّ عليّا وأهل بيته في كتاب اللّه عزّ وجلّ ؟ قال : فقال : قولوا لهم إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ اللّه لهم ثلاثا ولا أربعا ، حتّى كان
ص: 448
رسول اللّه صلى الله عليه و آله هو الذي فسّر ذلك لهم ، ونزلت عليه الزكاة ولم يسمّ لهم من كلّ أربعين درهما درهم(1) ، حتّى كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله هو الذي فسّر ذلك لهم ، ونزل : «وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ»، ونزلت في عليّ والحسن والحسين، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله في علي : "مَن كنت مولاه فعليّ مولاه" ، وقال صلى الله عليه و آله : "أوصيكم بكتاب اللّه وأهل بيتي، فإنّي سألت اللّه عزّ وجلّ أن لا يفرّق بينهما حتّى يوردهما عليَّ الحوض، فأعطاني ذلك" ، وقال صلى الله عليه و آله : لا تعلّموهم فهم أعلم منكم ، وقال صلى الله عليه و آله : "إنّهم لن يخرجوكم من باب هدىً ولن يدخلوكم في باب ضلالة" ، فلو سكت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولم يبيّن مَن أهل بيته، لادّعاها آل فلان وآل فلان ، لكنّ اللّه عزّ وجلّ أنزل في كتابه تصديقا لنبيّه صلى الله عليه و آله : «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا»(2) .
فكان علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام ، فأدخلهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله تحت الكساء في بيت أُمّ سلمة ، ثمّ قال : "اللّهمّ إنّ لكلّ نبي أهلاً وثقلاً، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي" ، فقالت أُمّ سلمة : ألست من أهلك ؟ قال : "إنّك إلى خير، ولكن هؤلاء أهلي وثقلي"، فلمّا قُبض رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان عليّ أولى الناس بالناس؛ لكثرة ما بلغ فيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وإقامته للناس وأخذه بيده ، فلمّا مضى عليّ لم يكن يستطيع عليّ ولم يكن ليفعل أن يدخل محمّد بن علي ولا العبّاس بن علي، ولا واحدا من ولده ، إذاً لقال الحسن والحسين: إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك، فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك، وبلغ فينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله كما بلغ فيك، وأذهب عنّا الرجس كما أذهبه عنك، فلمّا مضى عليّ عليه السلام كان الحسن عليه السلام أولى به؛ لكبره ، فلمّا توفّي لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك واللّه عزّ وجلّ يقول : «وَأُوْلُواْ الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ»، فيجعلها في ولده، إذا لقال الحسين: أمر اللّه بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك، وبلغ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كما بلغ فيك وفي أبيك، وأذهب اللّه عنّي الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك.
ص: 449
حتّى صارت إلى الحسين عليه السلام ، لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدّعي عليه كما كان هو يدّعي على أخيه وعلى أبيه، ولو أرادا أن يصرفا الأمر عنه ولم يكونا ليفعلا، ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسن عليه السلام ، فجرى تأويل هذه الآية : «وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ» .
ثمّ صارت من بعد الحسين لعليّ بن الحسين عليه السلام ، ثمّ صارت من بعد عليّ بن الحسين إلى محمّد بن علي عليه السلام . وقال : الرجس هو الشكّ ، واللّه لا نشكّ في ربّنا أبدا(1) .
وللمفسّرين في معنى «أولي الأمر» قولان آخران :
الأوّل : عن أبي هريرة - وفي روايةٍ عن ابن عبّاس وميمون بن مهران والسَّريّ والجَبّاني والبَلخِي والطبري - أنّهم الأُمراء .
الثاني : قال جابر بن عبد اللّه - وفي روايةٍ عن ابن عبّاس ومجاهد والحسن وعطاء وأبي العالية - أنّهم العلماء(2) .
وهذان القولان بعيدان كلّ البعد عن مضمون الآية الشريفة وأنّ المراد بأولي الأمر هم الأئمّة عليهم السلام، بنصّ الرواية التي أثبتناها أوّلاً عن الإمام الصادق عليه السلام ، إذ لا يجوز إيجاب طاعة أحد مطلقا إلاّ من كان معصوما مأمونا منه السهو والغلط، وليس ذلك بحاصل في الأُمراء ولا العلماء، وإنّما هو واجب في الأئمّة الذين دلّت الأدلّة على عصمتهم وطهارتهم ، فأمّا من قال المراد به العلماء، فقوله بعيد ؛ لأنّ قوله : «وأولي الأمر» معناه أطيعوا من له الأمر، وليس ذلك للعلماء .
فإن قالوا : يجب علينا طاعتهم إذا كانوا محقّين، فإذا عدلوا عن الحقّ فلا طاعة لهم علينا . قلنا : هذا تخصيص لعموم إيجاب الطاعة لم يدلّ عليه دليل .
ص: 450
وحمل الآية على العموم فيمن يتّضح ذلك فيه أولى من تخصيص الطاعة بشيءٍ دون شيء، كما لا يجوز تخصيص وجوب طاعة الرسول وطاعة اللّه في شيءٍ دون شيء(1) .
قال تعالى : «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ كِعُونَ»(2) .
روى الشيخ الكليني في باب «ما نصّ اللّه عزّ وجلّ ورسوله على الأئمّة عليهم السلام واحداً فواحدا»، بسندٍ متّصل عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ : «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ كِعُونَ» ؟ قال :
إنّما أولياؤكم أحقّ بكم وبأُموركم وأنفسكم وأموالكم ، اللّه ورسوله والذين آمنوا، يعني عليّا وأولاده الأئمّة عليهم السلام إلى يوم القيامة ، ثمّ وصفهم اللّه عزّ وجلّ ، فقال : «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ كِعُونَ»، وكان أمير المؤمنين عليه السلام في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع، وعليه حلّة قيمتها ألف دينار ، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله كساه إيّاها ، وكان النجاشي أهداها له ، فجاء سائل فقال : السلام عليك يا وليّ اللّه وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ، تصدّق على مسكين ، فطرح الحلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ فيه هذه الآية، وصيّر نعمة أولاده بنعمته، فكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدّقون وهم راكعون ، والسائل الذي يسأل أمير المؤمنين عليه السلام من الملائكة ،
والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة(3) .
ص: 451
ولم يختلف كثير من مفسّري العامّة في أنّ هذه الآية نزلت في عليّ عليه السلام ، كما دلّت رواية أبي عبد اللّه التي أثبتناها(1) .
ونقل كثير من المفسّرين وأصحاب الحديث هذه الرواية مرفوعة إلى الإمام الباقر عليه السلام أيضا(2) .
1 - قال تعالى : «وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَذَا الْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِى وَمَنم بَلَغَ»(3) .
نقل الكليني في باب «نكت ونتف من التنزيل في الولاية»، بسندٍ عن مالك الجهني قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام قول اللّه عزّ وجلّ : «وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَذَا الْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِى وَمَنم بَلَغَ» ؟ قال : من بلغ أن يكون إماما من آل محمّد فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول اللّه صلى الله عليه و آله (4) .
فإنّ «كلّ من بلغ لا يصلح أن يكون منذرا، بل هو من كان عالما بجميع ما فيه مثل النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ لكونه قائما مقامه، ولذلك فسّره عليه السلام بقوله : "من بلغ أن يكون إماما" من آل محمّد ؛ لاتّفاق الأئمّة على أنّ غيره لا يعلم جميع ما في القرآن»(5) .
ونقل العيّاشي وغيره عن الإمام الباقر والصادق عليهماالسلام هذا المعنى أيضا(6) .
2 - قال تعالى : «الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ»(7) .
ص: 452
روى الكليني في باب «نكت ونتف من التنزيل في الولاية»، بسندٍ عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قول اللّه عزّ وجلّ : «الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ» ؟ قال :
بما جاء به محمّد صلى الله عليه و آله من الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان، فهو الملبّس بالظلم(1) .
وقال صاحب مجمع البيان : «ولم يخلطوا ذلك بظلم ، والظلم هو الشرك»(2) .
وفسّر بعضهم الظلم بظلمٍ مخصوص ومعصية معيّنة، وهي الخلط المذكور . وفسّره بعضهم بالمعصية مطلقا(3) .
3 - قال تعالى : «لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَانِهَا خَيْرًا»(4) .
نقل الكليني في الباب نفسه تفسير هذه الآية بسندٍ عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله : «لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَانِهَا خَيْرًا»، قال :
الإقرار بالأنبياء والأوصياء وأمير المؤمنين عليهم السلام خاصّة ، قال : لا ينفع إيمانها ؛ لأنّها سلبت(5) .
أي لا ينفع نفسا إيمانها في ذلك اليوم باللّه وبالنبيّ والوصيّ إذا لم تكن آمنت في الميثاق باللّه، أو آمنت به ولم تكن آمنت فيه بالنبيّ والوصيّ، وإنّما لا ينفعها الإيمان في ذلك اليوم؛ لأنّها سلبت عن الإيمان، وتذهب من الدنيا بغير إيمان .
ويُفهم منه أنّ كل من لم يؤمن بأمير المؤمنين عليه السلام في الميثاق، لو آمن به في الدنيا لا ينفعه؛ لأنّه يموت بغير إيمان(6) .
ص: 453
قال صلى الله عليه و آله :
ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا : طلوع الشمس من مغربها، والدجّال، ودابّة الأرض(1) .
وقد روي عن الإمام الباقر مثل ذلك(2) .
وأخذ أكثر مفسّري الشيعة رواية الإمام الباقر والصادق عليهماالسلام التي ترجع إلى النبيّ صلى الله عليه و آله كما أثبتناه(3) .
1 - قال تعالى : «فَاذْكُرُواْ ءَالآَءَ اللَّهِ»(4) .
نقل الكليني في باب «إنّ النعمة التي ذكرها اللّه عزّ وجلّ في كتابه هم الأئمّة عليهم السلام» بسندٍ متّصل عن أبي يوسف البزّاز، قال :
تلا أبو عبد اللّه عليه السلام هذه الآية : «فَاذْكُرُواْ ءَالآَءَ اللَّهِ»، قال : أتدري ما آلاء اللّه ؟ قلت : لا ، قال : هي أعظم نعم اللّه على خلقه، هي ولايتنا(5) .
فالآلاء هي النعم ، وهم عليهم السلام من نعم اللّه على العباد، وولايتهم أعظم النعم ، وقد فسّر المفسّرون هذه الآية تفسيرا لغويا ولم يتأوّلوها .
2 - قال تعالى : «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الْأُمِّىَّ الَّذِى يَجِدُونَهُو مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى التَّوْرَاتِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَلَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِى وَعَزَّرُوهُ
ص: 454
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُو أُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(1) .
روى الكليني في باب «إنّ الأئمّة عليهم السلام نور اللّه عزّ وجلّ»، تفسير النور في هذه الآية بسندٍ عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «النور في هذا الموضع عليّ أمير المؤمنين والأئمّة عليهم السلام»(2) .
وقد فسّر غير واحد من العامّة النور بالقرآن والإسلام(3) ، وذهب إلى ذلك الطوسي من الشيعة(4) .
أقول : إنّ القرآن نور ، وإنّ الإسلام نور ، ولكنّ عبارة الإمام واضحة بيّنة، إذ قال: «النور في هذا الموضع...» ؛ لأنّ دلالات القرآن تختلف من موضعٍ لآخر وإن اتّفقت ألفاظها، ولا يعلم ذلك إلاّ اللّه والراسخون في العلم ، واعتقد أنّ الذي دفع المفسّرين بالاعتقاد أنّ النور معناه القرآن ، ففسّروا النور بالقرآن، بقرينة «أنزل»، والأولى أن يفسّر بعليّ وأولاده الطاهرين بقرينة «معه»، أي مع الرسول، إذ لو أُريد القرآن لقيل: «أُنزل إليه»، ولا يصحّ «أُنزل معه» .
وأمّا النزول، فلا يصحّ أن يُجعل قرينة لذاك دون هذا ؛ لأنّ النفوس القدسية
والأرواح النورانية نزلت من عند اللّه تعالى إلى عالمنا هذا لهداية الخلق كالقرآن، فلا
وجه لأن يجعل قرينة لأحدهما دون الآخر(5) .
3 - قال تعالى : «وَلِلَّهِ الأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا»(6) .
نقل الكليني في باب «النوادر»، بسندٍ متّصل عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ : «وَلِلَّهِ الأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا»، قال : «نحن واللّه الأسماء الحسنى التي لا يقبل اللّه من العباد عملاً إلاّ بمعرفتنا»(7) .
ص: 455
ويُلحظ أنّ الإمام يستعمل أُسلوب التوكيد بالقسم إذا فسّر القرآن تفسيرا عقائديا لتثبيت ذلك في نفس المتلقّي . والقسم أُسلوب من أساليب العربية المعتبرة .
وقد شرح المازندراني هذه الرواية شرحا واضحا لا لبس فيه، قال :
يُحتمل أن يراد بالأسماء الحسنى أسماؤهم عليهم السلام، وإنّما نسبها اللّه إليه لأنّه سمّاهم بها قبل خلقهم، كما دلّت عليهم بعض الروايات ، ويُحتمل أن يراد بها ذواتهم ؛ لأنّ الاسم في اللغة العلامة، وذواتهم القدسية علامات ظاهرة لوجود ذاته وصفاته، وصفاتهم النورية بيّنات واضحة لتمام أفعاله وكمالاته، وإنّما وصفهم بالحسنى - مع أنّ غيرهم من الموجودات أيضا علامات وبيّنات - لِمَا وجد فيهم من الفضل والكمال، ولمع منهم الشرف والجلال، ما لا يقدر على وصفه لسان العقول ، ولا يبلغ إلى كنهه أقطار الفحول، فهم من مظاهر الحقّ وأسمائه الحسنى وآياته الكبرى، فلذلك أمر سبحانه عباده أن يدعوه ويعبدوه بالتوسّل بهم والتمسّك بذيلهم(1) .
ولم يلتفت كثير من المفسّرين من الفريقين إلى هذه الرواية الشريفة ، فجاء تفسيرهم لهذه الآية تفسيرا طبيعيا، فقالوا : «إنّ للّه الأسماء الحسنى فادعوه بها»، وفسّروا الأسماء بالعلامات الدالّة على ذاته سبحانه، وأخذوا يعدّدون بعض سماته تعالى تلك .
والحقّ أنّ كلّ تفسير بعد تفسيرهم عليهم السلام باطل؛ لأنّهم هم القرآن الناطق، وهم الراسخون في العلم، وفي بيوتهم نزل القرآن، وهم بتفسيره وتأويله أعلم من سائر الخلق .
وقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام ، قال :
إذا نزلت بكم شدّة، فاستعينوا بنا على اللّه، وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها(2) .
ص: 456
قال تعالى : «وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا»(1) .
روى الكليني في باب «نكت ونتف من التنزيل في الولاية»، بسندٍ عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في قوله تعالى : «وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا»، قلت : ما السلم ؟ قال : «الدخول في أمرنا»(2) .
وفي تفسير العيّاشي وجامع الأحاديث عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد اللّه ، في قوله تعالى : «وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا»، فسأل: ما السلم ؟ قال : «الدخول في أمرنا»(3) .
وفسّرها كثير من المفسّرين تفسيرا ظاهريا لغويا، والمعنى إذا جنحوا للسلم، أي إذا مالوا إلى السلم، وهو نقيض الحرب(4) .
قال تعالى : «وَ كَانَ عَرْشُهُو عَلَى الْمَآءِ»(5) .
نقل الكليني في باب «العرش والكرسي»، بسندٍ معتبر عن داوود الرقّي، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ: «وَ كَانَ عَرْشُهُو عَلَى الْمَآءِ»؟ فقال : ما يقولون ؟ قلت : يقولون إنّ العرش كان على الماء والربّ فوقه ، فقال: كذبوا ، مَن زعم هذا فقد صيّر اللّه محمولاً ووصفه بصفة المخلوق، ولزمه أنّ الشيء الذي يحمله أقوى منه ، قلت : بيّن لي جُعلت فداك ؟ فقال : إنّ اللّه حمّل دينه وعلمه الماء قبل أن يكون أرض أو سماء أو جنّ أو إنس أو شمس أو قمر ، فلمّا أراد اللّه أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه ، فقال لهم : من ربّكم ؟ فأوّل من نطق رسول اللّه صلى الله عليه و آله
ص: 457
وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمّة صلوات اللّه عليهم ، فقالوا : أنت ربّنا، فحمّلهم العلم والدين ، ثمّ قال للملائكة : هؤلاء حملة ديني وعلمي وأُمنائي في خلقي، وهم المسؤولون ، ثمّ قال لبني آدم : أقرّوا للّه بالربوبية ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة ،
فقالوا : نعم ربّنا أقررنا ، فقال اللّه للملائكة : اشهدوا ، فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غدا : إنّا كنّا عن هذا غافلين، أو يقولوا: إنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرّية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ يا داوود، ولايتنا مؤكّدة عليهم في الميثاق(1) .
وقد أثبت كثير من أرباب الرواية وأصحاب الحديث هذا التفسير عن الإمام عليه السلام (2) .
سورة الرعد
قال تعالى : «قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَما بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِندَهُو عِلْمُ الْكِتَابِ»(3) .
نقل الكليني في بابٍ نادر فيه ذكر الغيب، رواية طويلة عن الإمام الصادق عليه السلام ، بسندٍ عن سدير، نقتطع منها ما يعطي تفسيرا للآية وينسجم والإيجاز الذي ننشده ، روى عن سدير، عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : «يا سدير، فهل وجدت فيما قرأت من كتاب اللّه عزّ وجلّ أيضا : «قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَما بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِندَهُو عِلْمُ الْكِتَابِ» ؟ قال : قلت: قد قرأته جُعلت فداك ، قال : أفمن عنده علم الكتاب كلّه أفهم، أم مَن عنده علم الكتاب بعضه ؟(4) قلت : لا، بل من عنده علم الكتاب كلّه . قال : فأومأ بيده إلى صدره وقال : علم الكتاب واللّه كلّه عندنا ، علم الكتاب واللّه كلّه عندنا»(5) .
ومعنى علم الكتاب في الآية الكريمة هو القرآن أو اللوح المحفوظ(6) .
ص: 458
فمحمّد وأهل بيته المعصومون أعلم بذلك وأفهم من سواهم ، وأثبت هذه الرواية بعض أصحاب الحديث وبعض المفسّرين(1) .
قال الشيخ الطوسي :
الذي عنده علم الكتاب هم أئمّة آل محمّد صلى الله عليه و آله . كما قال أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهماالسلام(2) .
في حين يرى غير الشيعة أنّ الذي عنده علم الكتاب هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين آمنوا ، أو هم جنس المؤمنين ، أو هو اللّه تعالى(3) .
1 - قال تعالى : «وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى»(4) .
نقل الكليني في باب «الروح» معنى الروح ، بسندٍ عن محمّد بن مسلم، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى»، كيف هذا النفخ ؟ فقال : إنّ الروح متحرّك كالريح، وإنّما سُمّي روحا لأنّه اشتقّ اسمه من الريح ، وإنّما أضافه إلى نفسه لأنّه اصطفاه على سائر الأرواح ، كما قال لبيتٍ من البيوت بيتي ، ولرسولٍ من الرسل خليلي ، وأشباه ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبّر(5) .
وقد أفاد المفسّرون من هذه الرواية في تفسيرهم ، قال الطوسي :
فالنفخ الإجراء لريحٍ في الشيء باعتماد ، فلمّا أجرى اللّه الروح على هذه الصفة في البدن، كان قد نفخ الروح فيه ، وأضاف روح آدم إلى نفسه تكرمة له، وهي إضافة إلى الملك لما شرّفه وكرّمه(6) .
ص: 459
2 - قال تعالى : «إِنَّ فِى ذَ لِكَ لَأَيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ * وَ إِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ»(1) .
لقد أورد الشيخ في باب «إنّ المتوسّمين الذين ذكرهم اللّه هم الأئمّة»، معنى المتوسّمين بروايةٍ عن أسباط بيّاع الزُّطيّ(2) ، قال:
كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام ، فسأله رجل عن قول اللّه عزّ وجلّ : «إِنَّ فِى ذَ لِكَ لَأَيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ * وَ إِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ» ؟ قال : فقال : نحن المتوسّمون، والسبيل فينا مقيم(3) .
والمتوسّمون «الذين يتوسّمون الأشياء ويتفرّسون في حقائقها وأسبابها وآثارها، ويتفكّرون في مبادئها وعواقبها، ويثبتون في النظر إليها حتّى يعرفوها بسماتها كما ينبغي . والسبيل المقيم - كما فسّره الإمام - هو الإمامة الثابتة لعترة الرسول»(4) .
قال تعالى : «وَ عَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ»(5) .
نقل الكليني في باب «إنّ الأئمّة عليهم السلام هم العلامات»، عن داوود الجصّاص ، قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «وَ عَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» قال : النجم رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، والعلامات هم الأئمّة عليهم السلام(6) .
إطلاق النجم على الرسول، وإطلاق العلامات على الأئمّة، يقرب أن يكون من باب الحقيقة ؛ لأنّ النجم في الأصل الظاهر والطالع، وأصل النجوم الظهور والطلوع، وهو صلى الله عليه و آله ظاهر من مطلع الحقّ وطالع من أُفق الرحمة(7) . وليس هذا من باب المجاز
ص: 460
للتشبيه بالنجم المعروف ؛ لأنّ النجم موجود وأنّ الرسول أشرف الموجودات، فلا يشبه بما هو أدنى منه، كما ظنّ كثير من المفسّرين ، وكذا إطلاق العلامات على الأئمّة تعبير حقيقي أيضا؛ لأنهم علامات للطرق الإلهيّة والقوانين الشرعية والنواميس الربّانية، وصفهم النبيّ صلى الله عليه و آله بأمر اللّه تعالى؛ لئلاّ يضلّ الناس بعده(1) .
2 - قال تعالى : «فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»(2) .
نقل الكليني في باب «إنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام» عن عبد الرحمن بن كثير، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : «فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»؟ قال : الذكر محمّد صلى الله عليه و آله ونحن أهله المسؤولون ، قال : قلت : قوله : «وَ إِنَّهُو لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسئَلُونَ» ؟(3) قال : إيّانا عنى، ونحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون(4) .
سورة الإسراء
قال تعالى : «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى»(5) .
نقل الكليني في باب «الروح التي يسدّد اللّه بها الأئمّة عليهم السلام» روايتين للإمام في
تفسير هذه الآية المباركة، بسندٍ عن أبي بصير، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى»؟ قال : خلقٌ أعظم من جبرئيل ومكيائيل، كان مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وهو مع الأئمّة، وهو من الملكوت .
وقال في روايةٍ أُخرى :
ص: 461
قال : خلقٌ أعظم من جبرئيل وميكائيل، لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد صلى الله عليه و آله ، وهو مع الأئمّة يسدّدهم، وليس كلّ ما طُلب وجد(1) .
وربّما عنى بقوله عليه السلام : «وليس كلّ ما طلب وجد»، أنّ وجوده مشروط بشروط، وهو بلوغ الطالب غاية الكمالات البشرية التي لا غاية فوقها، والبالغ إليها هو محمّد صلى الله عليه و آله وأوصياؤه الطاهرون عليهم السلام، ذلك فضل يؤتيه من يشاء، واللّه ذو الفضل العظيم(2) .
وأخذ بعض المفسّرين بالمعنى الذي ذكره الإمام، لكنّهم أضافوا لمعنى الروح معانٍ أُخرى، منها جبرئيل عليه السلام ، وقيل: هو روح الحيوان، وقيل: الروح هو القرآن(3) .
قال تعالى : «وَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَىُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا»(4) .
وقال تعالى : «مَن كَانَ فِى الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَ أَضْعَفُ جُندًا * وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْاْ هُدًى»(5) .
وقال تعالى : «لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا»(6) .
وقال تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا * فَإِنَّمَا
ص: 462
يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنذِرَ بِهِى قَوْمًا لُّدًّا»(1) .
نقل الكليني تفسير آيات من سورة مريم، بسندٍ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في قول اللّه عزّ وجلّ : «وَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَىُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا»، قال :
كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله دعا قريشا إلى ولايتنا، فنفروا وأنكروا ، فقال الذين كفروا من قريش للذين آمنوا الذين أقرّوا لأمير المؤمنين ولنا أهل البيت : «أَىُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا»، تعييرا منهم ، فقال اللّه ردّا عليهم : «وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا»(2)، قلت : قوله : «مَن كَانَ فِى الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا»؟ قال : كلّهم كانوا في الضلالة لا يؤمنون بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ولا بولايتنا، فكانوا ضالّين مضلّين، فيمدّ لهم في ضلالتهم وطغيانهم حتّى يموتوا، فيصيّرهم اللّه شرّا مكانا وأضعف جنداً . قلت : قوله : «حَتَّى إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَ أَضْعَفُ جُندًا»؟ قال : أمّا قوله :
«حَتَّى إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ»، فهو خروج القائم، وهو الساعة، فسيعلمون ذلك اليوم، وما نزل بهم من اللّه على يدي قائمه، فذلك قوله : «مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا « يعني عند القائم» وَ أَضْعَفُ جُندًا» .
قلت : قوله : «وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْاْ هُدًى»؟ قال: يزيدهم ذلك اليوم هدىً على هدىً باتّباعهم القائم، حيث لا يجحدونه ولا ينكرونه ، قلت : قوله : «لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا» ؟ قال : إلاّ من دان اللّه بولاية أمير المؤمنين والأئمّة من بعده، فهو العهد عند اللّه ، قلت : قوله : «إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا» ؟ قال : ولاية أمير المؤمنين، هي الودّ الذي قال اللّه تعالى عنه ، قلت : «فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنذِرَ بِهِى قَوْمًا لُّدًّا» ؟ قال : إنّما يسّره اللّه على لسانه حين أقام أمير المؤمنين عليه السلام
ص: 463
علما، فبشّر به المؤمنين، وأنذر به الكافرين، وهم الذين ذكرهم اللّه في كتابه لدّاً، أي كفّاراً(1) .
فقد دارت هذه الآيات الكريمة حول أمرين مهمّين من أُمور العقيدة، كما بيّن ذلك الإمام، ألا وهما التسليم بولاية أمير المؤمنين حين نصّ عليه القرآن ونُصب علماً من اللّه تعالى . والأمر الثاني الإشارة إلى ظهور القائم عجّل اللّه تعالى فرجه، وتبشير الإمامُ المؤمنينَ إذا هم اتّبعوه، فإنّ اللّه سيزيدهم هدىً إلى هداهم ، وأنذر من يتخلّف عنه بأنّهم شرُّ مكانا وأضعف جنداً .
وهذا إخبار بما سيأتي، وإنّه لا يتأتّى إلاّ لمن كانت عصمته نصّاً من اللّه، وهم الأئمّة المعصومون عليهم السلام الذين أطلعهم اللّه على علم الغيب .
فسلام عليهم في الأوّلين وفي الآخرين، والحمد للّه ربّ العالمين، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين .
إنّ من يبحث في قضية تتعلّق بالإمام وما يصدر عنه من روايات وأحاديث، كمن يبحر في بحرٍ وهو كسير المجاذيف، فلا قدرة له على استيعاب علم الإمام إلاّ بما يقسم اللّه له ويقدّر، وذلك بمَنٍّ منه ولطفٍ .
وقد عشت هذا المخاض العسير وأنا أحاول إدراك أو فهم رواية الإمام في التفسير، وكانت تجربة نافعة عشتها مع الكافي بما يتضمّنه من أحاديث وروايات عن الأئمّة عامّة ، وعن الإمام الصادق وتفسيره موضوع البحث خاصّة .
وتمخّض عن ذلك ما يمكن أن نطلق عليه منهج الإمام في التفسير، وهو بالوقت نفسه صورة للنتائج التي توصّل إليها هذا البحث، إذ كان الإمام يفسّر القرآن مجيباً عن
ص: 464
سؤال أصحابه، وربّما كان سؤالهم عن أجزاء الآيات، فيجيبهم على ذلك المقدار ، وربّما كان سؤالهم عن الآية كلّها، فيأتي تفسيره عنها أيضا . لذا كانت بعض الروايات طويلة شاملة، وقد تكون قصيرة مجتزئة تبعا لطبيعة السؤال .
وكان منهجه أيضا الاستشهاد بآيات أُخر في ثنايا تفسيره لآية من الآيات، ولا سيما تلك التي لها علاقة في معنى الآية التي يفسّرها، وكان عليه السلام يفسّر لأصحابه من غير سؤال منهم أيضا، فيسألهم ثمّ يجيب عن ذلك السؤال بتفسير الآية وتأويلها .
وكان يستعمل أُسلوب التوكيد في تفسيره، وخاصّة فيما يتعلّق بالعقيدة، كالولاية أو الإمامة، فإنّ ذلك من أساليب العربية الصحيحة، والإمام لا يخالف سنن العرب في كلامهم .
واللّه أعلم بذلك كلّه وأدرى .
ص: 465
1 . القرآن الكريم .
2 . أُصول الكافي ، أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329 ه ) ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، طهران : دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الثانية ، 1389 ه .
3 . الإنصاف فيما تضمّنه الكشّاف من الاعتزال ، الإمام ناصر الاسكندري ، القاهرة : مطبعة البابي الحلبي وأولاده ، الطبعة الأخيرة ، 1385 ه .
4 . التبيان في تفسير القرآن ، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت 460 ه ) ، تحقيق : أحمد حبيب قصير العاملي ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى ، 1206 ه .
5 . التفسير الأمثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، بيروت : مؤسّسة البعثة ، 1421 ه .
6 . تفسير البرهان (البرهان في تفسير القرآن) ، هاشم بن سليمان البحرانيّ (ت 1107 ه ) ، تحقيق : الموسويّ الزنديّ ، قمّ : مؤسّسة مطبوعات إسماعيليان ، الطبعة الثانية ، 1334 ه .
7 . تفسير أبي حمزة الثمالي ، جمع وتأليف : عبد الرزّاق محمّد حسين حرز الدين .
8 . تفسير الأصفى ، محمّد محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني (ت 1091 ه ) ، تحقيق : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ، الطبعة الأولى ، 1418 ه ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي .
9 . تفسير الإمام العسكري ، تحقيق ونشر : مدرسة الإمام المهدي عليه السلام ، قمّ ، 1406 ه .
ص: 466
10 . تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) ، أبو زيد عبد الرحمن محمّد بن مخلوف الثعالبي المالكي (ت 875 ه ) ، تحقيق : الإمام أبي محمّد بن عاشور ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى ، 1422 ه .
11 . تفسير جوامع الجامع ، الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548 ه ) ، تحقيق : مؤسّسة النشر
الإسلامي ، قمّ ، الطبعة الأولى ، 1418 ه .
12 . تفسير الطبريّ (جامع البيان في تفسير القرآن) ، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ (310 ه )، بيروت : دار الفكر ، 1415 ه .
13 . تفسير السمعاني ، أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني (ت 562 ه ) ، تحقيق : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عبّاس ، الرياض : دار الوطن ، الطبعة الأولى .
14 . الصافي فى تفسير القرآن (تفسير الصافي) ، محمّد محسن بن شاه مرتضى (الفيض الكاشانى) (ت 1091 ه ) ، طهران : مكتبة الصدر ، الطبعة الثانية ، 1419 ه .
15 . تفسير العيّاشي ، أبو النضر محمّد بن مسعود السلمي السمرقندي المعروف بالعيّاشي (ت 320 ه )، تحقيق : السيّد هاشم الرسولي المحلاّتي ، طهران : المكتبة العلميّة ، الطبعة الاُولى ، 1380 ه
16 . تفسير غريب القرآن الكريم ، فخر الدين الطريحي (ت 1085 ه ) ، تحقيق : محمّد كاظم الطريحي ، النجف ، 1953 م .
17 . تفسير فرات الكوفي ، أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (ق 4 ه ) ، إعداد : محمّد كاظم المحمودي ، طهران : وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1410 ه .
18 . تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ، أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيّ (ت 671 ه ) ، تحقيق : محمّد عبد الرحمن المرعشلي ، بيروت : دار إحياءالتراث العربيّ ، الطبعة الثانية ، 1405 ه .
ص: 467
19 . تفسير القمّي ، عليّ بن إبراهيم القمّي ، تحقيق : السيّد طيّب الموسوي الجزائري ، قمّ : مؤسّسة دار الكتاب للنشر ، الطبعة الثالثة ، 1404 ه .
20 . التفسير الكبير ومفاتيح الغيب (تفسير الفخر الرازي) ، أبو عبد اللّه محمّد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي (ت 604 ه ) ، بيروت : دار الفكر ، الطبعة الاُولى ، 1410 ه .
21 . تفسير مجاهد ، أبو الحجّاج مجاهد بن جبر المخزومي المكّي ( 103 ه ) ، تحقيق :عبد الرحمن الطاهر بن محمّد السورتي ، إسلام آباد : مجمع البحوث الإسلامية .
22 . تفسير الميزان (الميزان في تفسير القرآن) ، محمّد حسين الطباطبائيّ (1402 ه ) ، قمّ : منشورات جماعة المدرّسين .
23 . تفسير نور الثقلين ، عبد عليّ بن جمعة العروسيّ الحويزيّ (ت 1112 ه ) ، تحقيق : السيّد هاشم الرسوليّ المحلاّتيّ ، قمّ : مؤسّسة إسماعيليان ، الطبعة الرابعة ، 1412 ه .
24 . التوحيد ، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه ) ، تحقيق : هاشم الحسيني الطهراني ، قمّ : مؤسّسة النشر الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1398 ه .
25 . جامع أحاديث الشيعة ، البروجردي ، قمّ : المطبعة العلمية .
26 . زاد المسير في علم التفسير ، عبد الرحمن بن علي القرشي البغدادي (ابن الجوزي) (ت 597 ه ) ، تحقيق : محمّد عبد اللّه ، بيروت : دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 1407 ه .
27 . شرح أُصول الكافي ، محمّد صالح المازندراني (ت 1081 ه ) ، تصحيح : على¨ عاشور ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى ، 1421 ه .
28 . صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري (ت 261 ه ) ، تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي ، القاهرة : دار الحديث ، الطبعة الأولى ، 1412 ه .
29 . الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، محمود بن عمر الزمخشري (ت 538 ه ) ، القاهرة : مطبعة البابي الحلبي وأولاده ، 1385 ه .
30 . كنز الدقائق ، محمّد بن محمّد رضا المشهدي ، تحقيق : مجتبى العراقي ، قمّ : مؤسّسة النشر
ص: 468
الإسلامي ، 1407 ه . .
31 . مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو عليّ الفضل بن الحسن الطبرسيّ (ت 548 ه .) ، تحقيق : لجنة من العلماء والمحقّقين الأخصائيّين ، بيروت : منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ، الطبعة الأولى .
32 . المحرّر الوجيز ، ابن عطية الأُندلسي ، تحقيق : عبد اللّه بن إبراهيم الأنصاري وعبد العالم السيّد إبراهيم وصادق العتابي ، الدوحة ، 1412 ه .
33 . مختصر بصائر الدرجات ، حسن بن سليمان الحلّي (ق 9 ه ) ، النجف : منشورات المطبعة الحيدرية ، الطبعة الأولى ، 1270 ه .
34 . مسند الإمام الرضا عليه السلام ، تحقيق الشيخ عزيز اللّه عطاردي ، نشر المؤتمر العلمي العالمي للإمام الرضا عليه السلام ، 1406 ه .
35 . معاني القرآن الكريم ، أبو جعفر النحّاس ، تحقيق : محمّد علي الصابوني ، الطبعة الأولى ، 1408 ه .
36 . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمّد فؤاد عبد الباقي ، منشورات ذوي القربى ، مطبعة أميرات .
37 . موسوعة أحاديث أهل البيت عليهم السلام ، هادي النجفي ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى ، 1423 ه .
38 . الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو الحسن الواحدي ، تحقيق : صفوان عدنان داوودي ، دمشق : الدار الشامية ، الطبعة الأولى ، 1415 ه .
ص: 469
ص: 470
فهرس الموضوعات
مذكّرة أمين اللجنة العلمية للمؤتمر.......... 3
حياة الشيخ الكليني.......... 7
الأوّل: الحياة السياسية والفكرية في عصر الكليني.......... 7
المبحث الأوّل: الحياة السياسية والفكرية في الريّ.......... 8
المطلب الأوّل: الحياة السياسية في الريّ.......... 8
المطلب الثاني: الحياة الثقافية والفكرية في الري.......... 10
المذاهب والاتّجاهات الفكرية في الري.......... 11
1 - الخوارج.......... 12
2 - النواصب.......... 12
3 - المعتزلة.......... 12
4 - الزيديّة.......... 13
5 - النجّارية.......... 14
6 - المذاهب العامّية.......... 14
7 - المذهب الشيعي.......... 15
المبحث الثاني: بغداد سياسيا وفكريا في عصر الكليني.......... 16
المطلب الأوّل: الحياة السياسية ببغداد.......... 16
ص: 471
أوّلاً : نظام ولاية العهد.......... 17
ثانياً : عبث الخلفاء العبّاسيين ولهوهم وسوء سيرتهم.......... 17
ثالثاً : مجيء الصبيان إلى الحكم.......... 18
رابعاً : تدخّل النساء والخدم والجواري في السلطة.......... 18
خامساً : تدخّل الأتراك في سياسة الدولة وتحكّمهم في مصير العبّاسيين.......... 18
سادساً : تدهور الوزارة.......... 20
سابعاً : الثورات الملتزمة والحركات المتطرفة التي أضعفت السلطة.......... 20
ثامناً : انفصال الأقاليم واستقلال الأطراف.......... 21
المطلب الثاني: الحياة الثقافية والفكرية ببغداد.......... 21
أوّلاً : مركزية بغداد وشهرتها العلمية.......... 21
ثانياً : أوجه النشاط الثقافي والفكري والمذهبي ببغداد.......... 22
الثاني: الهوية الشخصية للشيخ الكليني.......... 24
توطئة.......... 24
أوّلاً : اسمه.......... 24
ثانياً : كنيته.......... 25
ثالثاً : ألقابه.......... 25
الصنف الأوّل : الألقاب المكانيّة.......... 25
1 - الكليني.......... 25
2 - الرازي.......... 26
3 - البغدادي.......... 26
4 - السلسلي.......... 26
الصنف الثاني : الألقاب العلميّة.......... 26
القسم الأوّل.......... 27
ص: 472
القسم الثاني.......... 27
رابعاً : ولادته.......... 27
خامساً : نشأته وتربيته، وعقبه، وأصله.......... 29
سادساً : وفاته، تاريخها ومكانها.......... 30
1 - تاريخ الوفاة.......... 30
2 - مكان الوفاة.......... 31
3 - قبره.......... 32
الثالث: أسفار الشيخ الكليني.......... 33
رحلته العلمية في طلب الحديث.......... 33
أسباب هجرة الكليني إلى بغداد.......... 34
الرابع: شيوخ الكليني وتلاميذه.......... 36
المبحث الأوّل : شيوخه.......... 36
1 - أحمد بن إدريس، أبو علي الأشعري.......... 36
2 - أحمد بن عبداللّه البرقي.......... 36
3 - أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهَمَدَاني.......... 37
4 - أحمد بن محمّد العاصمي.......... 37
5 - أحمد بن محمّد بن عبداللّه.......... 37
6 - أحمد بن محمّد بن علي.......... 38
7 - أحمد بن محمّد بن عيسى.......... 38
8 - أحمد بن مهران.......... 38
9 - إسحاق بن يعقوب الكليني.......... 39
10 - إسماعيل بن عبداللّه القرشي.......... 39
11 - حبيب بن الحسن.......... 39
ص: 473
12 - الحسن بن خفيف.......... 39
13 - الحسن بن علي الدينوري العلوي.......... 40
14 - الحسن بن علي الهاشمي.......... 40
15 - الحسن بن الفضل بن زيد اليماني.......... 40
16 - الحسين بن أحمد.......... 40
17 - الحسين بن الحسن الحسيني الأسود الهاشمي العلوي الرازي.......... 41
18 - الحسين بن محمّد بن عامر، أبو عبداللّه الأشعري.......... 41
19 - حُمَيْد بن زياد.......... 41
20 - داوود بن كُوْرَة، أبو سليمان القمّي.......... 42
21 - سعد بن عبداللّه الأشعري.......... 42
22 - سهل بن زياد، أبو سعيد الآدمي الرازي.......... 43
23 - عبداللّه بن جعفر الحِميَري.......... 43
24 - علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي.......... 43
25 - علي بن إبراهيم الهاشمي.......... 44
26 - علي بن الحسين السعدآبادي.......... 44
27 - علي بن محمّد بن سليمان.......... 44
28 - علي بن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه.......... 45
29 - علي بن محمّد الكليني الرازي.......... 45
30 - علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكُمَندانيّ.......... 46
31 - القاسم بن العلاء الهَمَداني.......... 46
32 - محمّد بن أحمد الخفاف النيسابوري.......... 46
33 - محمّد بن أحمد بن عبدالجبار.......... 47
34 - محمّد بن أحمد القمّي بن علي بن الصلت القمّي.......... 47
ص: 474
35 - محمّد بن إسماعيل.......... 47
36 - محمّد بن جعفر الأسدي.......... 48
37 - محمّد بن جعفر الرزّاز، أبو العبّاس الكوفي.......... 48
38 - محمّد بن الحسن الصفّار.......... 49
39 - محمّد بن الحسن الطائي الرازي.......... 49
40 - محمّد بن الحسن الطاطري.......... 49
41 - محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحِميَري.......... 49
42 - محمّد بن عقيل الكليني.......... 50
43 - محمّد بن علي أبو الحسين الجعفري السمرقندي.......... 50
44 - محمّد بن علي بن معمّر الكوفي.......... 50
45 - محمّد بن علي بن معن.......... 51
46 - محمّد بن محمود، أبو عبداللّه القزويني.......... 51
47 - محمّد بن يحيى العطّار.......... 51
48 - أبو بكر الحبّال.......... 52
49 - أبو حامد المراغي.......... 52
50 - أبو داوود.......... 52
مشايخ العدّة.......... 52
الطائفة الاُولى : العِدّة المعلومة.......... 53
1 - عِدَّة الكليني عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري.......... 53
2 - عِدَّة الكليني عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.......... 53
3 - عِدّة الكليني عن سهل بن زياد.......... 53
الطائفة الثانية : العِدّة المجهولة في «الكافي».......... 54
المبحث الثاني : تلاميذه والراوون عنه.......... 55
ص: 475
1 - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، أبو عبداللّه الصيمري.......... 55
2 - أحمد بن أحمد، أبو الحسين الكوفي الكاتب.......... 55
3 - أحمد بن الحسن (أو الحسين)، أبو الحسين العطّار.......... 55
4 - أحمد بن علي بن سعيد أبو الحسين الكوفي.......... 56
5 - أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد أبو الحسن القمّي.......... 56
6 - أحمد بن محمّد بن علي الكوفي.......... 56
7 - إسحاق بن الحسن بن بكران العقراني، أبو الحسن التمّار.......... 57
8 - جعفر بن محمّد بن قولويه.......... 57
9 - الحسن بن أحمد المؤدّب.......... 57
10 - الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب.......... 58
11 - الحسين بن صالح بن شعيب الجوهري.......... 58
12 - عبداللّه بن محمّد بن ذكوان.......... 58
13 - عبدالكريم بن عبداللّه بن نصر، أبو الحسين البزّاز.......... 59
14 - علي بن أحمد الرازي.......... 59
15 - علي بن أحمد بن محمّد بن عمران أبو القاسم الدقاق.......... 59
16 - علي بن أحمد بن موسى الدقّاق.......... 59
17 - علي بن عبداللّه الورّاق.......... 60
18 - علي بن محمّد بن عبدوس، أبو القاسم الكوفي.......... 60
19 - محمّد بن إبراهيم المعروف بابن أبي زينب النعماني.......... 60
20 - محمّد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب الشافعي.......... 60
21 - محمّد بن أحمد بن حمدون أبو نصر الواسطي.......... 61
22 - محمّد بن أحمد بن عبداللّه الصفواني.......... 61
23 - محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان، أبو عيسى الزاهري.......... 61
ص: 476
24 - محمّد بن الحسين البزوفري.......... 62
25 - محمّد بن علي بن أبي طالب أبو الرجاء البلدي.......... 62
26 - محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه.......... 62
27 - محمّد بن علي ماجيلويه.......... 63
28 - محمّد بن محمّد بن عصام الكليني.......... 63
29 - محمّد بن موسى المتوكّل.......... 64
30 - هارون بن موسى، أبو محمّد التلّعُكبري.......... 64
31 - أبو جعفر الطبري.......... 64
32 - أبو الحسن بن داوود.......... 65
33 - أبو سعد الكوفي.......... 65
34 - أبو غالب الزُّرَاري.......... 65
35 - أبو المفضّل الشيباني.......... 66
الخامس: مؤلّفات ثقة الإسلام الكليني.......... 66
أوّلاً : كتاب تعبير الرؤيا.......... 66
ثانياً : كتاب الردّ على القرامطة.......... 67
ثالثاً : كتاب رسائل الأئمّة عليهم السلام.......... 68
رابعاً : كتاب الرجال.......... 69
خامساً : كتاب ما قيل في الأئمّة عليهم السلام من الشعر.......... 69
سادساً : كتاب خصائص الغدير، أو خصائص يوم الغدير.......... 69
سابعاً : كتاب الكافي.......... 70
حكاية عرض «الكافي» على الإمام المهدي عليه السلام .......... 71
موقف علماء الشيعة تجاه أحاديث «الكافي».......... 73
منهج الكليني في أسانيد «الكافي».......... 73
ص: 477
منهج الكليني في متون «الكافي».......... 76
تبويب وترتيب «الكافي».......... 77
السادس: ما قاله العلماء بحقّ الكليني.......... 80
أوّلاً : ثناء علماء الشيعة على ثقة الإسلام الكليني.......... 80
ثانياً : ثناء علماء العامّة على الكليني.......... 84
ثالثاً : ثناء المستشرقين على الكليني.......... 86
المحدّث الكليني وأثره الخالد.......... 87
أُسرته.......... 87
الظروف الّتي نشأ فيها.......... 88
ثقافته الواسعة.......... 90
أثره الخالد.......... 91
ثناء العلماء وأقوالهم فيه.......... 92
رحلاته في أخذ الحديث وعرض كتابه.......... 93
العناية بكتاب «الكافي».......... 95
الكليني وتهمة تحريف القرآن.......... 97
وهناك اقتراحات أُخرى نذكرها تباعا.......... 98
منهجية الكليني في «الكافي».......... 101
تقديم.......... 101
منهجية الشيخ الكليني في «الكافي».......... 102
توطئة تمهيدية: المنهج لغةً واصطلاحا.......... 102
أوّلاً : المنهج لغةً.......... 102
ثانيا: المنهج اصطلاحا.......... 102
المطلب الأوّل: تصنيف الكتاب.......... 103
ص: 478
المطلب الثاني: تبويب الأُصول.......... 103
المطلب الثالث: تبويب الفروع.......... 104
المطلب الثالث: تبويب الفروع.......... 105
المطلب الرابع: تبويب الروضة.......... 105
الفصل الأوّل: المنهجية العامّة.......... 106
المبحث الأول: أُسلوب العرض - المقدّمة الاعتقادية.......... 106
المبحث الثاني: المباحث غير التخصّصية.......... 107
1 - علم التاريخ.......... 107
2 - الأخلاق أو العرفان أو السلوك.......... 107
3 - علم الكلام.......... 108
الفصل الثاني : المنهجية الفنّية.......... 109
المبحث الأوّل : معالجة السند.......... 109
أوّلا : إيراد السلسلة السندية كاملة.......... 109
ثانياً : توصيف رجال سنده.......... 109
ثالثاً : رجال الطبقات.......... 111
1 - تعدّدية الرواة في طبقةٍ واحدة.......... 111
2 - تعدّدية الرواة في أكثر من طبقة.......... 111
رابعاً : معالجة الطرق - تعدّدية طرق الأسناد.......... 111
خامسا: إيجاز إسناده.......... 112
سادسا: تكييف مصادر السند.......... 113
1 - المصادر الاعتيادية.......... 113
2 - المصادر الاستثنائية.......... 113
المبحث الثاني : معالجاته في المتن.......... 114
ص: 479
توطئة تمهيدية.......... 114
المطلب الأوّل: التقديم لأحاديثه.......... 115
المطلب الثاني : إيضاح المصطلحات القرآنية.......... 115
المطلب الثالث: فقه السنّة.......... 117
المطلب الرابع: المفردة العربية.......... 117
المطلب الخامس: الشواهد الشعرية.......... 117
الفصل الثالث: «الكافي» بين التأثّر والتأثير.......... 118
المبحث الأوّل : تأثّر «الكافي» بما قبله.......... 118
وتتابعت المصنّفات بعد ذلك حتّى قال الشيخ المفيد.......... 119
المبحث الثاني: كتاب «الكافي».......... 120
المبحث الثالث: تأثير «الكافي» فيما بعده.......... 121
الخاتمة والنتائج.......... 122
المصادر والمراجع.......... 124
عِدّاتُ الكليني ومشايخه.......... 127
من هو الكليني ؟.......... 127
تقديم.......... 128
الكليني وعِدّاته.......... 130
العِدّة الاُولى.......... 133
أوّلهم : محمّد بن يحيى.......... 133
منزلته عند الرجاليّين.......... 133
الثاني : علي بن موسى الْكُمَنْداني.......... 134
كلام مع صاحب المعالم.......... 137
الثالث : داوود بن كُوْرَة القمّي.......... 140
ص: 480
الرابع : أحمد بن إدريس «أبو عليّ الأشعري» القمّي.......... 141
الخامس : علي بن إبراهيم بن هاشم القمّى ، أبو الحسن.......... 142
العدّة الثانية.......... 147
أوّلهم على ترتيب «الخلاصة» : علي بن إبراهيم.......... 147
الثاني : عليّ بن محمّد بن عبد اللّه بن أُذينة.......... 148
الثالث : أحمد بن عبد اللّه بن أُميّة.......... 150
الرابع : علي بن الحسن.......... 151
العدّة الثالثة.......... 159
أوّلهم : علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني ، المعروف بعلاّن.......... 159
الثاني : محمّد بن أبي عبد اللّه.......... 160
الثالث : محمّد بن الحسن.......... 163
الرابع : محمّد بن عقيل الكليني.......... 164
مشايخ الكليني.......... 168
الأوّل: أحمد بن إدريس.......... 168
الثاني: أحمد بن عبد اللّه بن أُميّة.......... 168
الثالث: أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن زياد بن عبد اللّه............. 168
الرابع : أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة أبو عبد اللّه.......... 174
الخامس : أحمد بن مهران.......... 175
السادس : إسحاق بن يعقوب.......... 176
السابع : حبيب بن الحسن.......... 177
الثامن : الحسن بن خفيف.......... 177
التاسع : الحسن بن الفضل بن زيد اليماني.......... 177
العاشر : الحسين بن الحسن الهاشمي العلوي.......... 179
ص: 481
الحادي عشر: الحسين بن علي العلوي.......... 179
الثاني عشر: الحسين بن محمّد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمّي أبو عبد اللّه.......... 179
الثالث عشر: حميد بن زياد بن حمّاد بن حمّاد بن زياد هَوَاز الدهقان أبو القاسم.......... 180
الرابع عشر: داوود بن كورة.......... 181
الخامس عشر: سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الأشعري.......... 181
السادس عشر: سليمان بن سفيان ، المكنّى بأبي داوود المسترقّ.......... 183
المصادر والمراجع.......... 191
الراويات النساء من كتاب «الكافي» للكليني.......... 195
الأحاديث و راوياته في الأُصول والفروع والروضة.......... 196
1 - أُصول الكافي.......... 196
2 - فروع الكافي.......... 202
منهج الكليني بسند الحديث.......... 207
طبقات الراويات النساء من كتاب «الكافي» وفروعه.......... 211
علاقة الأحاديث بأبوابها.......... 214
الخاتمة.......... 218
المصادر والمراجع.......... 219
إحداثيات الفكر الاثني عشري بين الكليني والصدوق دراسة فلسفية - كلامية.......... 221
المقدّمة.......... 221
الحقبة الاُولى : الشيخ الكليني والنزعة المحافظة.......... 223
خلاصة القول.......... 241
نظرية المعرفة عند الإمامية مرويات «الكافي» مستندا.......... 243
المقدّمة.......... 243
المبحث الأوّل : قيمة العقل في مرويات «الكافي».......... 246
ص: 482
المبحث الثاني : إمكان المعرفة.......... 248
المبحث الثالث : غاية المعرفة.......... 251
المبحث الرابع : مصادر المعرفة.......... 252
المبحث الخامس : مسالك المعرفة.......... 258
قضايا المعرفة.......... 260
الخاتمة.......... 261
القرآن الكريم كما تصوّره روايات أُصول الكافي.......... 263
أوّلاً : القرآن الكريم والعقيدة والمفاهيم المنبثقة عنها.......... 264
ثانياً : القرآن الكريم وتربية المشاعر.......... 267
ثالثاً : القرآن والسلوك.......... 269
وخلاصة الأمر.......... 269
الشيخ الكليني والتحريف.......... 270
موقف الكليني من القول بتحريف القرآن في كتاب « الكافي».......... 273
المقدّمة.......... 273
المبحث الأوّل : قراءة استدلالية لمصاديق المقدّمة الاُولى.......... 276
المبحث الثاني : قراءة استدلالية لمصاديق المقدّمة الثانية.......... 279
النصوص التي استدلّوا بها على وجود نقص في النصّ القرآني.......... 287
المبحث الثالث : قراءة استدلالية في مصاديق المقدّمة الثالثة.......... 290
الخاتمة.......... 292
المصادر والمراجع.......... 295
«صيانة القرآن» بين الخفاء والجلاء.......... 297
المقدّمة.......... 297
أوّلاً : المقدّمات.......... 297
ص: 483
1 - أهمّيّة القرآن.......... 297
2 - المراد من التحريف.......... 298
أ - التحريف لغةً.......... 299
ب - محلّ النزاع في تحريف القرآن.......... 299
3 - أساس شبهة التحريف.......... 302
4 - الأُمور التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار في فهم الحديث.......... 302
ثانياً : الأحاديث المدّعى دلالتها على التحريف.......... 304
الطائفة الاُولى.......... 305
الطائفة الثانية.......... 305
الطائفة الثالثة.......... 306
الطائفة الرابعة.......... 307
الطائفة الخامسة.......... 308
الطائفة السادسة.......... 308
الطائفة السابعة.......... 309
ثالثاً : الاحتمالات المتصوّرة في هذه الروايات وتقييمها.......... 309
1 - أن تكون موضوعة ولا أساس لها.......... 310
2 - أن يكون المقصود منها إثبات تحريف القرآن بحذف بعض ألفاظه.......... 311
أ . اهتمام المسلمين بالقرآن على مدى العصور.......... 312
ب . عدم انسجام القول بالتحريف مع روح الروايات الأُخرى.......... 313
3 - أن يراد بها التفسير وبيان أحد الوجوه.......... 315
أ . صفات المجتمع الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه و آله .......... 315
ب . وسائل الكتابة وأثرها على عرض المعلومات.......... 323
ج . عدم التصريح في شيء من الروايات بحذف شيء من القرآن.......... 324
ص: 484
د . عدم إيراد شيء من الروايات المذكورة في كتاب القرآن من «الكافي».......... 325
ه- . الروايات المشابهة للروايات المبحوث عنها.......... 327
و . اختلاف لحن وأُسلوب أهل البيت عليهم السلام عن لحن وأُسلوب القرآن الكريم.......... 333
ز . تضمين الكلام بالآيات الكريمة.......... 333
ح . فهم العلماء لهذه الروايات.......... 337
ط . ملاحظة العناوين الواردة في اللغة والروايات.......... 338
التأويل لغة.......... 339
النزول لغةً.......... 340
النزول والتأويل في الروايات.......... 340
ى . الدقّة في الدلالة.......... 343
ك . اختلاف نُسَخِ الحديث.......... 344
ل . دقة النقل وأثرها على توهّم التحريف.......... 346
رابعاً : دراسة في المصادر الأصليّة التي رويت عنها هذه الروايات.......... 349
1 - الروايات التي ورد في أسانيدها «المنخَّل عن جابر».......... 349
2 - الروايات التي ورد في أسانيدها «المعلّى بن محمّد».......... 354
3 - الروايات التي ورد في أسانيدها «أبو حمزة».......... 356
4 - الروايات التي ورد في أسانيدها «محمّد بن الفضيل».......... 359
خامساً : مناهج مواجهة هذه الروايات.......... 362
زبدة المخاض.......... 363
منهج تفسير القرآن بالقرآن في مرويات الكافي للشيخ الكليني.......... 367
المطلب الأوّل : بيان إبهام دلالة حرمة الخمر في لفظة «الإثم».......... 373
المطلب الثاني : بيان إبهام حدّ التيمّم.......... 386
المطلب الثالث : بيان إبهام لفظة «الأبصار» للّه تعالى.......... 390
ص: 485
المطلب الرابع : بيان إبهام لفظة «المصلّين» في آية سورة المدثّر.......... 394
الخاتمة.......... 400
المصادر والمراجع.......... 404
الأثر التفسيري في روايات «الكافي» كتاب الزكاة أُنموذجا.......... 407
المقدّمة.......... 407
الكليني وكتابه «الكافي».......... 409
«الكافي».......... 410
تمهيد.......... 411
الروايات التفسيرية في «الكافي».......... 411
بيان تفسيري لمرادف لفظٍ قرآني.......... 414
بيان دلالة مفردة.......... 416
بيان ضابطة في التمييز بين صنفين.......... 419
بيان تفسيري بتقدير متعلّق.......... 421
بيان الفرد أو المصداق الأظهر.......... 424
نتائج البحث.......... 427
المصادر والمراجع.......... 428
إشارات إلى تفسير الإمام الصادق عليه السلام في أُصول الكافي قراءة تحليلية موازنة.......... 435
الإهداء.......... 435
المقدّمة.......... 435
سورة البقرة.......... 437
سورة آل عمران.......... 442
سورة النساء.......... 445
سورة المائدة.......... 451
ص: 486
سورة الأنعام.......... 452
سورة الأعراف.......... 454
سورة الأنفال.......... 457
سورة هود.......... 457
سورة الرعد.......... 458
سورة الحجر.......... 459
سورة النحل.......... 460
سورة الإسراء.......... 461
سورة مريم.......... 462
الخاتمة ونتائج البحث.......... 464
المصادر والمراجع.......... 466
ص: 487
بطاقة تعريف: کنگره بین المللی بزرگداشت ثقةالاسلام کلینی(ره) (1388 : شهرری)
عنوان المؤلف واسمه: مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني/ ویراستار حسین پورشریف.
تفاصيل النشر: قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر: سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 1387.
مشخصات ظاهری : 5ج.
فروست : پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛ 192.
مجموعه آثار کنگره بین المللی بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی؛ 40، 41، 42، 43، 44.
شابک : 64000 ریال
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج.1. مباحث کلی.- ج.2. مباحث کلی.- ج.3. مصادر و اسناد کافی.- ج.4. مباحث فقه الحدیثی.- ج.5. مباحث فقه الحدیثی.
موضوع : کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. -- کنگره ها
موضوع : کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. -- نقد و تفسیر
موضوع : کلینی، محمد بن یعقوب - 329ق. . الکافی -- نقد و تفسیر
موضوع : محدثان شیعه -- ایران -- کنگره ها
معرف المضافة: پورشریف، حسین، 1354 -، ویراستار
تصنيف الكونجرس: BP129 /ک8ک2057 1388
تصنيف ديوي: 297/212
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 8 8 5 5 3 6
ص: 1
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 2
مجموعه مقالات الموتمر الدولی للشیخ ثقه الاسلام الکلینی
الموتمر الدولی للشیخ ثقه الاسلام الکلینی
الجزء الثانى
ص: 3
عنوان و نام پديدآور : مجموعه مقالات الموتمر الدولی للشیخ ثقه الاسلام الکلینی/الموتمر الدولی للشیخ ثقه الاسلام الکلینی
مشخصات نشر : قم: دار الحدیث:سازمان اوقاف و امورخیریه، 1429ق=1387.
مشخصات ظاهری : 2ج.
فروست : مرکز بحوث دار الحدیث؛ 196
مجموعه آثار الموتمر الدولی لذکری الشیخ ثقه الاسلام الکلینی؛ 45،46
وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
شماره کتابشناسی ملی : 1885954
ص: 4
الآخر في فكر الكليني، المعتزلة أُنموذجا 7
د. حسين عبيد الشمّري
د. عبد اللّٰه حبيب
علم الأئمّة عليهم السلام بالغيب والاعتراض عليه بالإلقاء للنفس إلى التهلكة و... 29
السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي
قصص الكافي دراسة ونقد 137
الشيخ هادي حسين الخزرجي
سمات الشخصية المؤمنة وأنماطها في فكر الإمام عليّ عليه السلام في كتاب أُصول الكافي... 173
د. علي شاكر عبد الأئمّة الفتلاوي
حسن شاكر الفتلاوي
بلاء يوسف عليه السلام في الكافي ونجاته بآل محمّد عليهم السلام مرويات الكافي (مستنداً) 195
صبيح نومان الخزاعي
دراسة حول الأبعاد الفقهية في تراث الشيخ الكليني 213
الشيخ صفاء الدين الخزرجي
ص: 5
بحوث فقهية (المباني الفقهية للمحدّثين في ضوء كتاب الكافي...) 259
حيدر محمّد علي السهلاني
أشعار الكافي دراسة تحليلية 295
د. عبد الإلٰه عبد الوهّاب العرداوي
مختارات من نوادر «روضة الكافي» للكليني 315
د. مهدي صالح سلطان
الفهارس العامّة 339
فهرس الموضوعات 431
ص: 6
الحمد للّٰه الذي بعث في الأُميّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإنْ كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطيّبين الطاهرين.
لقد وقع اختياري على موضوع «الآخر في فكر الكليني»؛ لما له من أهمّية كبيرة في حياتنا المعاصرة في الميادين الاجتماعية والسياسية والدينية في مجتمعاتنا الإسلامية. وقد أفادت هذه الدراسة من الدراسات المعرفية والجمالية في تأسيس صورة الآخر، فضلاً عن كتب التفاسير والنقد وغيرها، فجاءت الدراسة مقسّمة على مبحثين مسبوقة بمقدّمة، وملحقة بخاتمة سُجّل فيها أهمّ النتائج التي توصّل إليها الباحث.
لقد اقتضى البحث في صورة الآخر عند الشيخ الكليني أن يُقسّم على مبحثين، فكان المبحث الأوّل بعنوان «الآخر في اللغة والاصطلاح»، وقد تمّ بحث المصطلح
ص: 7
في الدراسات اللغوية والمعرفية، وأمّا المبحث الثاني فقد حَمَل عنوان «الآخر العقدي، المعتزلة وصور الاختلاف والمغايرة»، وتمّ جمع المادّة من خلال ردود الشيخ الكليني رحمه الله وتصوّراته الخاصّة في إرساء دعائم مدرسة أهل البيت عليهم السلام ودفاعه عن الإسلام.
وبعد، فإن بدرت منّي زلّة أو عثرة فإنّي أطمع من الباري عز و جل غفرانها لي، وحسبي في كلّ ذلك إخلاص النيّة وسلامة القصد؛ لأنّي طالب علم وعملي جهد بشر مجبول على النقص. وآخر دعوانا أنّ الحمدُ للهِ ربِّ العَالَمِين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الطاهرين.
أوّلاً: الآخر لغةً
جاء في معجم العين:
تقول: هذا آخر، وهذه أُخرى... والآخر: الغائب.... وأمّا آخر فجماعة أُخرى(1).
أمّا في الصحاح فقد جاء:
الآخر - بالفتح -: أحد الشيئين، وهو اسم على افعل، والأُنثى أُخرى... وآخر: جمع أُخرى، وأُخرى تأنيث أخر، وهو غير مصروف، قال اللّٰه تعالى: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» (2)(3).
وقد قال صاحب اللسان:
والآخر: بمعنى غير، كقولك: رجل آخر وثوب آخر، وأصله افعل من التأخّر، فلمّا اجتمعت همزتان في حرفٍ واحد استُثقلتا، فأُبدلت الثانية ألفاً؛ لسكونها وانفتاح الأُولى قبلها... وتصغير آخر أويخر، وجرت الألف المخفّفة عن الهمزة مجرى ألف
ص: 8
ضارب، وقوله تعالى: «فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا»(1) ، فسّره ثعلب فقال: فمسلمان يقومان مقام النصرانين، وقال الفرّاء: معناه أو آخران من غير دينكم من النصارى واليهود... والجمع بالواو والنون، والأُنثى أُخرى(2).
ويبدو أنّ أصل اشتقاق هذا اللفظ يرجع إلى معنى التأخّر الذي هو ضدّ التقدّم؛ لأنّ (الغير) يأتي لاحقاً للأصل وخلافاً له، يقول ابن فارس:
الهمزة والخاء والراء أصل واحد ترجع فروعه وهو خلاف التقدّم، وهذا قياس أخذناه عن الخليل(3).
أمّا في تاج العروس فقد ورد:
الآخر: بمعنى غير، كقولك: رجل آخر وثوب آخر، وأصله افعل من تأخّر؛ فمعناه أشدّ تأخّراً، ثمّ صار بمعنى المغاير. وقال الأخفش: لو جعلت في الشعر آخر مع جابر لجاز... وقد جمع امرؤ القيس بين الآخر وقيصر بوهم الألف همزة(4)، فقال(5):
إذا نحن سرنا خمسَ عشرة ليلةٍ *** وراء الحِساءِ مِن مَدافِعُ قَيصرا
إذا قلتُ هذا صاحبٌ قد رضيتُهُ *** وقَرّت به العينان بُدِّلتُ آخرا
ويضيف الأصفهاني (ت 502 ه) في مفرداته:
إنّ مدلول الآخر في اللغة خاصّ بجنس ما تقدّمه، فلو قلت: جاءني رجل وآخر معه، لم يكن الآخر إلّامن جنس ما قلته(6).
لقد أجمعت المعاجم أنّ «الآخر» يأتي بمعنى الغير، سواء أكان إنساناً او شيئاً آخر، وتشمل تلك المغايرة العدد والماهيّة(7). أمّا في القرآن الكريم فقد وردت لفظة «آخر»
ص: 9
بعدّة صيغ:
في صيغة المفرد المذكّر (آخر) وردت في (15) موضعاً، منها قوله تعالى: «إِذْ قَرَّبٰا قُرْبٰاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمٰا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ اَلْآخَرِ»(1).
في صيغة المفرد المؤنّث (أخرى) وردت في (23) موضعاً، منها قوله تعالى: «أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا اَلْأُخْرىٰ »(2).
في صيغة المثنّى (آخران) وردت في موضعين، منها قوله تعالى: «اِثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »(3).
في صيغة الجمع (أخَر) وردت في خمسة مواضع، منها قوله تعالى: «مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ »(4).
في صيغة الجمع (آخرون) فقد وردت في (5) مواضع، منها قوله تعالى:
«وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صٰالِحاً»(5) . أمّا في صيغه الجمع (آخرين)، فقد وردت في (17) موضعاً، منها قوله تعالى: «سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ »(6).
يتّضح من خلال ما تقدّم أنّ لفظة «الآخر» جاءت بصيغها كلّها في القرآن الكريم، عدا جمع المؤنّث السالم (أُخريات)، وقد أوحت تلك الصيغ على أنّ الآخر هو
ص: 10
الشيء أو الشخص المغاير بالجنس أو النوع أو الصفة.
ثانياً: الآخر اصطلاحاً
ليس من شك أنّ عملية اكتشاف الآخر لا تتمّ بمعزلٍ عن الأنا والذات، فأينما وُجِد الآخر فالأنا بشكل بديهي تكون مقابلاً لهذا الآخر(1). هذا وسنسعى إلى تلمّس مفهوم الآخر في الدراسات الدينية بصورة عامّة وعند الشيخ الكليني بصورة خاصّة.
إنّ ما يؤسّسه الخطاب حول الآخر هو: «خطاب حول الاختلاف، فإنّ التساؤل فيه ضروري حول الأنا أيضاً، ذلك أنّ هذا الخطاب لا يقيم علاقة بين حدّين متقابلين، وإنّما علاقة بين آخر وأنا متكلّم عن هذا الآخر، وتناول الاختلاف لا يفضي إلى نفي الجدلية بين الذات والآخر، ولا إلى جوهرة الهوية»(2). هذا وقد ركّزت الدراسات الفلسفية والاجتماعية والنفسية على مستويات الآخر بالدراسة والبحث بحسب الاختلاف الفكري أو العرقي.(3)
تبدو إشكالية الآخر في الوعي الديني أكثر تعقيداً؛ لما لها من مستويات مختلفة في التناول والدراسة، وقد تناولت هذه الدراسات الآخر (المؤسّساتي الفقهي) في علاقته بغيره، إذ مايزت هذه الدراسات بين «ما هو قدسي متعالٍ ، وما يحيل على ترجمتها الدنيوية التاريخية، فهي تختزن تصوّراً للكون والطبيعة والإنسان، وتقترح نمطاً من الاعتقاد يرمي بالمؤمن في مناخ ذهني ووجداني يدفع به إلى الانخراط في حركية دائمية للتماهي بين ذاته وموضوع إيمانه».(4)
ص: 11
فثنائية الصراع التي قدّمتها الديانة القديمة (الخير والشرّ) كانت البذرة الاُولى في تجسيد صورة الآخر (العدوّ)، إذ «يمارس الناس الصراع المقدّس في العالم المادّي، ويتشكّل التاريخ من خلال الصراع بين قوى الظلام وقوى النور، بين الخير والشرّ...
وسيطاح - نتيجة لذلك - بقوى الظلام، وتتجدّد الأرض فتصبح في حالٍ من النظارة والطهارة؛ لأنّها لهما».(1)
ليست المعضلة الوعي بوجود آخر يشاركني الوجود فقط، بل الوعي بآخر «يشاركني الحقيقة، هذه الحقيقة التي طالما تيقّنت أنّ إشعاعها يخرج من هنا الممتلئ إلى هناك الخواء والفراغ، إلى الأماكن البعيدة الباردة الحالكة الظلام، وإذا في لحظة مشاركة وجدانية وحالة قصد وانشداد ادع هذا الآخر يتفتّح أمامي بنفسه».(2)
إنّ الحاجة إلى الآخر هي حاجة وجودية يتوقّف عليها وجود الذات، وبما أنّ الوجود كلّه عبارة عن وحدات بينهما علاقات تتوقّف عليها وجود تلك الوحدات، صحّ القول إنّ العلاقات بين وحدات هذا الوجود (الطبيعي - الاجتماعي)، التي هي بالأصل مجموعة علاقات بين ذوات وآخر.
نظراً لاتّساع مفهوم «الآخر» ومطاطية المصطلح، اقتصر بعض الدارسين على إطار العلاقات البشرية مع الآخر، أي ما كان بعض أو كلّ أطرافها من البشر، وأهملوا الجوانب الأُخرى.
انطوى تصوير الشيخ الكليني على أنماط متنوّعة وصور مختلفة من صور الآخر، ولكي يقف الدارس على أدقّ المعالم التي رسمها الكليني للآخر، ينبغي عليه «تلمّس منطوق النصّ المحدّد لمعالم الرؤية التي يحملها عن الآخر، وعن المضامين المختلفة التي يمنحها للغير المخالف له في الملّة والدين، وبحكم الترابط بين
ص: 12
العقائدي والروحي والقدسي والرمزي في الإسلام، فإنّ البعض قد يركّز في مقاربته لهذا الموضوع، على البعد الميتافيزيقي الذي يحمله النصّ ».(1)
يتجلّى حضور الآخر في هذا العالم في مستويات متعدّدة بحسب فعل الفهم للنصّ القرآني، إذ يعدّ الشرط الرئيس في تحديد معالم الآخر وتحوّلاته وطرائق التعامل معه؛ لأنّ النصّ القرآني «هو الفضاء الدلالي لصورة اللّٰه في الوعي الإنساني وقناة العبور إلى مقاصد اللّٰه»(2). إذ إنّ العلاقة مع الآخر تحدّدها وجهة التسليم بقصدية الخلق، وما يترتّب على هذه العلاقة بمختلف صورها، وهي علاقات مقنّنة، أي تخضع عموماً لقوانين وسنن معيّنة، وقد حقّق الإنسان تقدّماً ملحوظاً في اكتشاف بعض قوانين العلاقة مع الآخر في المجال المادّي، بينما ما زال كسب الإنسان في اكتشاف سنن العلاقة مع الآخر في المجال الاجتماعي محدوداً.
لقد اختصّ البحث بصورة الآخر الفكري عند الشيخ الكليني رضى الله عنه المغاير أو المتمايز في العقيدة والأفكار، فثمّة صور متنوّعة للآخر الذي يتغاير بالقياس إلى النوع (الملائكة، الجنّ ، إبليس)، عرضها شيخنا ضمن شبكة علائقية ردّاً على معتقدات القدرية من جهة، ومدافعاً عن العقيدة الإمامية من جهةٍ أُخرى، وقد جسّد القرآن الكريم هذا العنصر في حوارات متعدّدة، بدءاً من نشأة الخليقة والتكوين، إلى مميزات الذات الإنسانية وسلوكياتها المحبّبة والمرفوضة، وما يترتّب عليها من انفصال أو اندماج.
لذلك نرى أنّ هذا العنصر يجيء تارةً على ألسنة الملائكة في إثبات صفة الطاعة والعبودية، كقوله تعالى: «أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا وَ يَسْفِكُ اَلدِّمٰاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ »(3) ، ويجيء تارةً على لسان إبليس، كقوله تعالى: «قٰالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ
ص: 13
نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ».(1)
وقد شكّل هذا التمايز النوعي صورة من صور الآخر - في النشأة والتكوين - يمكن بحثها في دراسات لاحقة، وإذا ما تدرّجنا بعد ذلك إلى المواقف الإنسانية والأفكار والوظائف والمعتقدات والسلوكيات والأحكام الشرائعية، تظهر لنا صورة أُخرى من هذا الآخر عند الشيخ الكليني أدرجها ضمن أبواب مختلفة، مثل صفات الأنبياء والأئمّة عليهم السلام،(2) والأحكام الشرائعية.(3)
المعتزلة وصور الاختلاف والمغايرة
تتشكّل صورة هذا «الآخر» على وفق التصوّرات العقائدية التي تعتنقها الفئة وما تفرز هذه التصوّرات من مرجعيات متعدّدة حول أُمور التوحيد والخلق والعدل، وما يترتّب على هذه المرجعيات في التغاير والمخالفة(4)، وهي على مستوياتٍ عدّة.
المعتزلة هي مدرسة فكرية عاشت في أكناف أهل السنّة، وبعد زمن من نشوئها حدث الخلاف بين رجالها وبين أهل السنّة، مماّ ولّد ذلك الخصام تراثاً عقلياً لكلا المذهبين أغنت المكتبة الإسلامية طيلة قرون عديدة، إلّاأنّ هجمات أهل السنّة على المعتزلة كان عنيفاً جدّاً، بل إنّهم شوّهوا عقائدهم ورموهم بشتى التهم والمساوئ، وقبّحوا عقائدهم، حتّى أظهروهم للملأ الإسلامي أنّهم مرقوا عن الدين، وأوجدوا البدع فيه.
ظهرت مدرسة الاعتزال في بداية القرن الثاني الهجري في البصرة، وما للبصرة
ص: 14
آنذاك من شموخ في عالم العلم والأدب والثقافة، وملتقى العلماء والأدباء وأهل الكلام.
للمعتزلة أسماء مختلفة، منها أسماء خاصّة، وأُخرى عامّة. فأمّا الخاصّة فهي مقتصرة على طائفة منهم، ولا يبعد أن تكون مشتقّة من بعض عقائدهم، نذكر منها:
1 - الحرقية؛ لقولهم: الكفّار لا يُحرقون إلّامرّة.
2 - المفنية؛ لقولهم بفناء الجنّة والنار.
3 - الواقفية؛ لقولهم بالوقف في خلق القرآن.
4 - اللفظية؛ لقولهم: ألفاظ القرآن مخلوقة.
5 - الملتزمة؛ لقولهم: اللّٰه تعالى في كلّ مكان.
6 - القبرية؛ لإنكارهم عذاب القبر.(1)
وأمّا الأسماء العامّة والمشهورة بين المؤرّخين والعلماء، فهي:
1 - المعتزلة: وهو أشهر أسماء هذه المدرسة، والسبب في هذه التسمية كما يذكره البغدادي في كتابه إذ يقول:
إنّ أهل السنّة هم الذين دعوهم معتزلة؛ لاعتزالهم قول الأُمّة بأسرها في مرتكب الكبيرة من المسلمين، وتقريرهم أنّه لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر(2).
وقد ذكر الشهرستاني سبباً آخر، فقال:
إنّ واصل بن عطاء مؤسّس المدرسة حين اختلف مع الحسن البصري في مسألة مرتكبي الكبائر وأدلى برأيه فيها، اعتزل مجلس الحسن هو وبعض من وافقه على ذلك الرأي، وجلس قرب إحدى أُسطوانات المسجد يشرحه لهم، فقال الحسن البصري: اعتزل عنّا واصل، فسُمّي هو وأصحابه معتزلة(3).
ص: 15
ويرى البعض أنّ الذي سمّاهم بهذا الاسم هو قتادة بن دعامة السدوسي (ت 117 ه)، وكان قتادة من علماء البصرة وأعلام التابعين(1).
ولعلّ فكرة الاعتزال لم تأت من إطلاق شخص لتسمية مجموعةٍ ما، أو أنّ فلاناً اعتزل أصحابه فسُمّي ومن معه بالمعتزلة، بل إنّ التسمية جاءت لمعتقدٍ فكري، وهذا المعتقد هو الذي أوجد لهم هذه التسمية. وممّا يؤيّد هذا المفهوم ما تعارف عليه أهل اللغة من إضافة كلمة «أهل» إلى مبدأ ما أو عقيدة أو فكرة.
2 - أهل العدل والتوحيد: أطلق المعتزلة على أنفسهم اسم أهل العدل والتوحيد، إذ إنّهم يعنون بالعدل هو نفي القدر، والقول بأنّ الإنسان هو موجد أفعاله، تنزيهاً للّٰه تعالى عن أن يُضاف إليه الشرّ. ويعنون بالتوحيد هو نفي الصفات القديمة، والدفاع عن وحدانية اللّٰه جلّ شأنه. فالمعتزلة تفتخر بهذه التسمية، ويفضّلونها على سائر الأسماء(2).
3 - أهل الحقّ : ومن الأسماء المحبّذة التي أطلقها المعتزلة على أنفسهم اسم «أهل الحقّ »، حيث يرون أنفسهم هم الفرقة الناجية، بل يرون أنّ غيرهم على باطل! هذه بعض الأسماء المحبّذة التي أطلقها المعتزلة على أنفسهم، إلّاأنّ خصومهم - ولاختلافهم في المعتقد والتفكير - أطلقوا على المعتزلة عدّة أسماء وعناوين، معتمدين في ذلك على المعتقدات التي التزمها المعتزلة في تفكيرهم، والتي أصبحت أُصولاً لمذهبهم. وعلى الإجمال نذكر بعضها:
أ. المعطّلة: أصل التسمية كانت تُطلق على مذهب الجهمية، نسبة إلى مؤسّسها الأوّل جهم بن صفوان، (ت 128 ه)، والمدرسة الجهمية ظهرت قبل المعتزلة، إذ كانت تنفي الصفات عن اللّٰه جلّ شأنه، أي تجريده تعالى منها،
ص: 16
ولمّا ظهرت المعتزلة أخذت عن الجهمية قولها بنفي الصفات، فلزمهم الاسم المتقدّم «المعطّلة».
ومن معاني التعطيل، هو تعطيل ظواهر الكتاب والسنّة عن المعاني التي تدلّ عليها، وقد لجأ المعتزلة إلى الآيات التي لا توافق مشاربهم وأفكارهم إلى تأويلها، ولا يستبعد أن يكون ذلك سبباً في هذه التسمية. ومن أشهر الكتّاب الذين أطلقوا هذه التسمية على المعتزلة هو ابن القيّم الجوزية(1).
ب. الجهمية: وهي نسبة إلى مؤسّس المدرسة جهم بن صفوان، ظهرت هذه المدرسة قبل المعتزلة، وقالت بالجبر، وخلق القرآن، ونفي الصفات، وإنكار الرؤية، ولمّا ظهرت المعتزلة أخذت ببعض أقوال هؤلاء، وانتحلت أفكارهم، ممّا كان سبباً في تسميتهم من قبل أهل السنّة بالجهمية. والجدير بالذكر أنّ الردود التي كُتبت من قبل علماء السنّة المتأخّرين كابن حنبل ومن جاء بعده، إنّما كانوا يقصدون بالجهمية هم المعتزلة. أمّا علماء السنّة المتقدّمين على ابن حنبل، إنّما كانت ردودهم على الجهمية هي الاُولى، أتباع جهم بن صفوان؛ لأنّهم أسبق من المعتزلة(2).
ج. القدرية: من عقائد المعتزلة قولهم بأنّ الناس هم الذين يُقدّرون أعمالهم، وأنّ اللّٰه سبحانه ليس له فيها صنع ولا تقدير، غير أنّ هذا المعتقد كان سائداً بين مجموعة سبقت المعتزلة ذات مدرسة متميّزة، مؤسّسها معبد الجهني وغيلان الدمشقي، القائلين بالقدر خيره وشرّه من اللّٰه سبحانه. ولمّا كان المعتزلة يعتبرون غيلان الدمشقي واحداً منهم، وهذا من القائلين بالقدر، إذن من البديهي أن يتّفقا على هذه التسمية، بل قل: إنّ المؤرّخين لم يفرّقوا بين الطائفتين(3).
ص: 17
والمعتزلة تعتقد بأُصولٍ خمسة، هي:
1 - التوحيد.
2 - العدل.
3 - الوعد والوعيد.
4 - المنزلة بين المنزلتين.
5 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أمّا ما اتّفق فيه من الصفات بينهم، فقد اتّفقت المذاهب الثلاثة (الإمامية والمعتزلة والأشاعرة) على جملة أُمور، منها:
1 - إنّ صفات اللّٰه سبحانه منها ما هو ذاتي ثابت لذاته، كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر، ومنها ما هو إضافي يثبت لذاته بعد وجود المنشأ لانتزاعها، كالرازق والخالق والمالك والمميت، وغير ذلك ممّا تتّصف به الذات بعد وجود منشأ لانتزاعها؛ لأنّ صدق الخالق والمالك والرازق والمميت عليه سبحانه إنّما صحّ باعتبار وجود المخلوق والمملوك والإماتة.
2 - قسّم المتكلّمون الصفات إلى قسمين: سلبية وثبوتية، فالسلبية: هي نفي ما لا يليق بذاته عنه؛ لكونه جسما أو جوهرا أو عرضا... والثبوتية: فهي التي تليق بذاته، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والمحيي والرازق.
3 - اتّفق الإمامية والمعتزلة على عدم كونه جسماً؛ لأنّ كونه جسماً يلزمه أن يكون متحيّزاً، وأن يكون جوهراً لو كان متحيّزاً، وإذا كان جوهراً، فإمّا أن لا ينقسم أصلاً، أو ينقسم، وكلاهما لا يجوز عليه سبحانه.
أمّا الأوّل: فلأنّ الجوهر الذي لا ينقسم هو الجزء الذي لا يتجزّأ، والجزء الذي لا يتجزّأ أصغر الأشياء، وتعالى اللّٰه عن ذلك.
وأمّا الثاني: فلو انقسم كان جسماً مركّباً، والتركيب الخارجي يتنافى مع الوجود
ص: 18
الذاتي.
هذا بالإضافة إلى أنّه لو كان متحيّزا لكان مساوياً لسائر المتحيّزات في الماهية، واللّازم من ذلك إمّا القدم أو الحدوث؛ لأنّ المتماثلات لابدّ من توافقها في الأحكام.
هذه جملة من العقائد عند المعتزلة والأشاعرة ما اختلفوا فيها وما اتّفقوا عليها.
هذه الحالات التي جنتها أيدي علمائهم، وتلك المنافسات التي اشتركت فيها أغلب الفرق الإسلامية والاتّجاهات العلمية، صيّرت من علماء الشيعة الإمامية أن يقفوا ضدّ كلّ تيارٍ منحرف، أو عقيدة خاطئة، لأجل ذلك تظافرت الهمم، ودخل علماء الإمامية في تلك المناظرات بكلّ إمكانياتهم العلمية ليضعونها للمسلمين، ومن خلال ذلك النزاع برزت مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وقد نقلها لنا الشيخ الكليني بكلّ أمانة ودقّة، بل اهتمّ كثيراً في إبراز معالم هذه المدرسة بتبويب الأحاديث وتصنيفها وفق المسائل التي كانت بارزة، والتي هي مدار بحث وجدل، وفي مقدّمة تلك المسائل موضوع التوحيد
يعدّ موضوع الشرك والتوحيد من أهمّ المسائل الاعتقادية التي تصّدرت المفاهيم والتعاليم السماوية، بل هي الأولى في تبليغ الرسل ورفض الشرك والوثنية، قال تعالى:
«وَ لَقَدْ بَعَثْنٰا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا اَللّٰهَ وَ اِجْتَنِبُوا اَلطّٰاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اَللّٰهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ اَلضَّلاٰلَةُ فَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَةُ اَلْمُكَذِّبِينَ »(1) .
لقد أولى الشيخ الكليني هذا الأصل العقائدي أهمّية كبرى، فالتوحيد هو: «الاعتقاد بتوحيد اللّٰه تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وخلقه مخلوقاته ومعبوديته وإدارته مخلوقاته»(2)، وعملية التوحيد في الصفات والذات ترتبط بفعل الفهم والإدراك وما
ص: 19
يتبعها من خطوات أُخرى بطبيعة الحال.
لذا نرى الكليني يفصّل مراتب التوحيد؛ فمنها ما يكون في الذات، الصفات الربوبية والتدبير، الطاعة، العبادة(1).
يقصد بتوحيد الصفات، هو أنّه «لا يمتلك أحد الصفات الإلهيّة وهو وحيد في صفاته ومتفرد بها، علمه وقدرته ورحمته وحكمته موجودة فيه على نحوٍ استقلالي ولم يأخذها من آخر، عكس الإنسان، فقد اكتسب قدرته وعلمه من اللّٰه ولم تكن فيه على نحو الاستقلال»(2).
والصفات الذاتية للذات المقدّسة وإن تعدّدت «كالعلم والقدرة والحياة، إلّاأنّ هذا التعدّد إنّما هو باعتبار المفهوم الذهني وليس باعتبار الوجود والواقع الخارجي، بمعنى أنّ كلّ واحدة من هذه الصفات هي عين الأُخرى وليست غير الأُخرى، وهي أجمع عين الذات وليست غير الذات»(3)، قال تعالى: «أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيٰاءَ فَاللّٰهُ هُوَ اَلْوَلِيُّ وَ هُوَ يُحْيِ اَلْمَوْتىٰ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ»(4) ، فالآية الكريمة تؤكّد صفة الولاية والقدرة المطلقة للّٰه (عزّ وجلّ )، وأنّه أولى بالخلق من أنفسهم؛ لأنّه خلقهم، وهو القادر على إحيائهم وإماتتهم، فهو المحيي والمميت، وأنّ قدرته بلا حدود(5).
لقد ذكر الشيخ الكليني في باب الصفات وحدة الذات المقدّسة فقدرتها مطلقة، وعليه ينبغي أن تكون الولاية لها مطلقة، لذا فإنّ رؤية هذا الآخر العقدي (المعتزلة) في
ص: 20
كيفية بعض هذه الصفات، فتح باب الجدل في إقرار هذه الصفات وصحّة معتقدهم، يقول الشيخ في صفات الذات: «وقع العلم منه على المعلوم والسمع على المسموع والبصر على المبصر والقدرة على المقدور... أي وقع على ما كان معلوماً في الأزل وانطبق عليه وتحقّق مصداقه، وليس المقصود تعلّقه به تعلّقاً لم يكن قبل الإيجاد والمراد بوقوع العلم على المعلوم العلم به على أنّه حاضر موجود وكان قد تعلّق العلم به قبل ذلك على وجه الغيبة وأنّه سيوجد، والتغيّر يرجع إلى المعلوم لا إلى العلم»(1).
قال تعالى: «تَنْزِيلُ اَلْكِتٰابِ مِنَ اَللّٰهِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَلِيمِ * غٰافِرِ اَلذَّنْبِ وَ قٰابِلِ اَلتَّوْبِ شَدِيدِ اَلْعِقٰابِ ذِي اَلطَّوْلِ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ»(2) .
هذه الصفات التي لا يتّصف بها سوى اللّٰه(3)، فسياق الآية الكريمة ذكر (المغفرة والتوبة والعقوبة)؛ لدفع هذا الآخر أو ذاك من أعباء الذنوب الحاصلة في الحياة الدنيا بالإقرار أنّ اللّٰه ذو مغفرة واسعة(4)، ثمّ انتقل الخطاب القرآني إلى توحيد الذات «لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ» ، ثمّ يعود إلى صفة القدرة «إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ» ، هذه الصفة التي توحي باستباق الأحداث للوصول بهذا الآخر أو ذاك إلى اليقين المتحقّق في اليوم الموعود، الأمر الذي ناسب فيه بين صفتي العزّة والعلم في الآية الاُولى «اَلْعَزِيزِ اَلْعَلِيمِ » ، وصفة المصير والرجوع في هذا اليوم الذي لا يعلمه إلّاهو.
ذكر الشيخ أنّ إرادة «اللّٰه، الفعل، لا غير ذلك، يقول له: كن فيكون، بلا لفظٍ ولا نطق بلسان ولا همّة ولا تفكّر ولا كيف لذلك، كما أنّه لا كيف له»(5).
لقد أنكر المعتزلة كلّ الصفات، سواء كانت حقيقية أم قديمة أم متميّزة عن الجوهر، وقالوا: هي مجرّد اعتبارات ذهنية، بل إنّهم قالوا: هي نفس الجوهر. ثمّ
ص: 21
يقولون: لمّا كانت الذات الإلهيّة ذاتاً واحدة غير منقسمة، ونحن غير قادرين على إدراكها، تصوّرنا فيها هذه الاعتبارات الذهنية، وهي الصفات، وكلّ ما يطلقونه من الصفات إنّما يجعلونها أوجه لذات واحدة بسيطة، لا قسمة فيها ولا كثرة ولا تركيب.
لقد استخدموا العقل والأدلّة والحجج العقلية في تناول المسائل الكلامية، استطاعوا أن يحرزوا تأييد الخلفاء والأُمراء العبّاسيين، حتّى تمكّنوا في مدّة وجيزة أن ينشروا بدعة خلق القرآن بأمر المأمون، غير أنّ ذلك لم يدم طويلاً حتّى جاء عصر المتوكّل العبّاسي الذي أطاح بهم، وجعل كلّ من يقول بخلق القرآن دمه مهدور وهو كافر. لقد كان عمرو بن عبيد من أقرب الأصدقاء إلى الخليفة المنصور العبّاسي، وكان أبو الهذيل أُستاذاً للمأمون(1).
أجمعت المعتزلة على أنّ للعالم محدثاً قديماً، قادراً، عالماً، حيّاً لا لمعان، ليس بجسم ولا عرض، ولا جوهر، عيناً واحداً، لا يُدرك بحاسّة، عدلاً حكيماً، لا يفعل القبيح ولا يريده، كلّف تعريضاً للثواب، ومكّن من الفعل، وأزاح العلّة، ولابدّ من الجزاء من وجوب البعثة حيث حسنت، ولابدّ للرسول من شرع جديد، أو إحياء مندرس، أو فائدة لم تحصل من غيره، وأنّ آخر الأنبياء محمّد صلى الله عليه و آله، والقرآن معجزة له، وأنّ الايمان قول ومعرفة وعمل، وأنّ المؤمن من أهل الجنّة، وعلى المنزلة بين المنزلتين هو أنّ الفاسق لا يُسمّى مؤمناً ولا كافراً، إلّامن يقول بالإرجاء، فإنّه يخالف في تفسير الإيمان.
ثمّ قالوا: إنّ الفاسق يُسمّى مؤمناً، وأجمعوا أنّ فعل العبد غير مخلوق فيه، وأجمعوا على تولّي الصحابة، واختلفوا في عثمان بعد الأحداث التي أحدثها، فأكثرهم تولّاه، وتأوّل له، وأكثرهم على البراءة من معاوية وعمرو بن العاص، وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ص: 22
وأجمعوا على نفي الصفات الأزلية عن اللّٰه سبحانه، وقولهم بأن ليس للّٰه عزّ وجلّ علم ولا قدرة ولا حياة، ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلية، بل قالوا: إنّ اللّٰه تعالى لم يكن في الأزل اسم ولا صفة.
أجمعوا باستحالة رؤية اللّٰه عزّ وجلّ بالأبصار، وزعموا أنّه لا يرى نفسه، ولا يراه غيره، واختلفوا فيه، هل هو راء لغيره أم لا، فأجازه قوم منهم، وأباه آخرون منهم.
وأجمعوا على حدوث كلام اللّٰه سبحانه - أي أنّ كلامه مخلوق -، وحدوث أمره ونهيه وخبره، فزعم القدامى منهم بأنّ قول اللّٰه حادث، والمتأخّرون قالوا: إنّ كلامه مخلوق.
وأجمعوا بأنّ اللّٰه تعالى غير خالق لأكساب الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات، أي أنّ أفعال الحيوانات خارجة عن قدرة اللّٰه، وقد زعموا أنّ الناس هم الذين يقدّرون أكسابهم، ولهذا سمّاهم المسلمون بالقدرية.
وأجمعوا على أنّ الفاسق من المسلمين هو بالمنزلة بين المنزلتين، وهي أنّه فاسق، لا مؤمن ولا كافر. وأجمعوا على أنّ كلّ ما أمر اللّٰه تعالى به أو نهى عنه من أعمال العباد، لم يشأ منها(1).
ذكر الشيخ قائلاً:
عن مبروك بن عبيد، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: لعن اللّٰه القدرية، لعن اللّٰه الخوارج، لعن اللّٰه المرجئة. لعن اللّٰه المرجئة. قال: قلت: لعنت هؤلاء مرّة مرّة، ولعنت هؤلاء مرّتين ؟! قال: إن ّ هؤلاء يقولون: إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطّخة بثيابهم إلى يوم القيامة(2).
ثمّ أورد حديثاً عن:
محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل ين يسار،
ص: 23
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: لا تجالسوهم - يعني المرجئة - لعنهم اللّٰه ولعن مللهم المشركة الذين لا يعبدون اللّٰه على شيء من الأشياء(1).
ذكرهم الشيخ قائلاً:
المشهور بين الأصحاب أنّهم كفّار يُستمالون للجهاد. قال المفيد رحمه اللّٰه: المؤلّفة قسمان: مسلمون، ومشركون في القواعد... المؤلّفة قسمان: كفّار يُستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام، ومسلمون(2).
عن أبي جعفر عليه السلام قال:
المؤلّفة قلوبهم قوم وحّدوا اللّٰه وخلعوا عبادة [من يعبد] من دون اللّٰه، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول اللّٰه، وكان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يتألّفهم ويعرفهم؛ لكيما يعرفوا ويعلّمهم(3).
عن سهل بن زياد، عن علي بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن رجل، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
ما كانت المؤلّفة قلوبهم قطّ أكثر منهم اليوم، وهم قوم وحّدوا اللّٰه وخرجوا من الشرك ولم تدخل معرفة محمّد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله قلوبهم وما جاء به، فتألّفهم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله وتألّفهم المؤمنون بعد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله؛ لكيما يعرفوا(4).
أصل البحث لمفهوم الآخر في الدراسات المعرفية والجمالية، فظهر أنّ الآخر هو المغاير يأتي بمعنى الغير، سواء أكان أنساناً أو شيئاً آخر، وتشمل تلك
ص: 24
المغايرة العدد والماهية.
إنّ مسألة الاختلاف تحيل إلى وجودٍ آخر يتمايز ويتراتب في صراعٍ عقائدي أو فكري شرائعي، أو سلوكي يندمج بعدها أو يفارق حسبما يقتضيه الخطاب، فكلّ طائفة ترى أنّها صاحبة الحقّ والأولوية والصواب، ولهذا تعدّدت صور الآخر واتّسعت دائرته لتشمل كلّ المواقف والمناهج المتبعة من كلّ ذات، فالوعي بظاهرة الاختلاف والتمايز يجسّد الآخر بوصفه اختلافاً دينياً أو ثقافياً، سواء تقدّم باعتباره شريكاً مسالماً أو في هيئة كيانٍ غازٍ أو في صفة محتلٍّ ، أو تقدّم إلى مساحة الوعي كاختلافٍ جسدي أو ثقافي، لذا صوّر لنا الشيخ الكليني خلال حديثه عن الفرق أشخاصاً ينتمون إلى هذا الفكر أو ذاك، إلّاأنّه في مواطنٍ أُخرى قصد السلوكيات الشخصية والخلقية التي تُمارس باسم هذا الدين أو ذاك المعتقد بغير حقّ . ومن جهةٍ أُخرى ذكر لنا بعض الصفات الممدوحة والمتمايزة بحسب التجربة والممارسة التي أفضت إلى تراتبيات جمالية في المثال (الجلال - الجمال)، والصفات المذمومة (القبح)، والتراتبية الاجتماعية التي أعطت لهذا الفرد أو ذاك حقّ التمايز والتراتب والاصطفاء؛ الأمر الذي مكّنه من حمل الفكر المغاير وتبليغه.
خلاصة القول: إنّ البحث في صور الآخر عند الشيخ بحاجة إلى دراسة متأنّية يقف بها الدارس على أدقّ المعالم التي رسمها الشيخ في تحوّلات الآخر بعد ممارسة التجربة الدينية، يمكن بحثها في قابل الأيّام. وآخر دعوانا أنّ الحمد للّٰه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الطاهرين.
ص: 25
1. القرآن الكريم.
2. أمثال القرآن، آية اللّٰه العظمى ناصر مكارم الشيرازي، إعداد: أبو القاسم عليان نسدي، تعريب: تحسين البدري، قم: مطبعة، أمير المؤمنين عليه السلام، 1421 ه.
3. الأنا والآخر والجماعة، دراسة في فلسفة سارتر ومسرحه، سعاد حرب، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع (دراسات فلسفية)، الطبعة الاُولى، 1415 ه 1994 م.
4. تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: مجموعة من الأساتذة.
5. التعريفات، أبو الحسن علي بن محمّد بن علي الجرجاني (ت 816 ه)، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامّة.
6. جمالية الخطاب القرآني دراسة في صورة الآخر، حسين عبيد الشمّري، أُطروحة دكتوراه، جامعة القادسية كلّية الآداب، 2007 م.
7. دراسة في أُسس الإسلام، مجتبى الموسوي اللّاري، تلخيص: رضا المحمّدي، ترجمة:
كمال السيّد، مركز نشر الثقافة الإسلامية في العالم، 1418 ه 1998 م
8. ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف بمصر، سلسلة ذخائر العرب (24)، الطبعة الثانية، 1964 م.
9. الشخصانية الإسلامية، د. محمّد عزيز الحبابي، القاهرة: دار المعارف بمصر، 1969 م.
10. الشخصية السلمية، دراسة للشخصية من وجهة نظر علم النفس الإنساني، سيدني. م.
جورارد، تيد لندزسن، ترجمة: د. حمد دلي الكربولي وموفق الحمداني، بغداد: مطبعة التعليم العالي، جامعة بغداد، 1988 م.
ص: 26
11. صفوة التفاسير، محمّد علي الصابوني، دار القلم، بيروت - لبنان، ط 5، 1986.
12. صورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه، تحرير: الطاهر لبيب، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الجمعية العربية لعلم الاجتماع، الطبعة الاُولى، 1999 م.
13. الغرب المتخيّل صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسيط، محمّد نور الدين أفاية، بيروت: المركز الثقافي العربي، الطبعة الاُولى، 2000 م.
14. القاموس المحيط، مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 817 ه)، مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1952 م.
15. كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175 ه)، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، بغداد: دار الحرّية للطباعة، 1984.
16. كتاب المعارف، ابن قتيبة الدينوري، طبعة مصر، 1353 ه.
17. الكليني والكافي، الشيخ الدكتور عبد الرسول عبد الحسن الغفّار، نشر مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة الاُولى، 1416 ه.
18. لسان العرب المحيط، محمّد بن مكرم الأنصاري ابن منظور (ت 711 ه)، إعداد وتصنيف:
يوسف خيّاط، بيروت: دار لسان العرب.
19. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمّد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار الكتب المصرية.
20. مفاهيم قرآنية، جعفر السبحاني، تحقيق: جعفر الهادي، مؤسّسة الامام الصادق، 1420 ه.
21. مفردات غريب القرآن، العلّامة الراغب الإصفهاني (ت 502 ه)، تحقيق: نديم مرعشلي، مطبعة التقدّم العربي، توزيع: دار الفكر، 1392 ه.
22. الملل والنحل، الشهرستاني، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1980 م.
23. من وحي القرآن، محمّد حسين فضل اللّٰه، بيروت: دار الملاك، الطبعة الثانية، 1419 ه.
ص: 27
ص: 28
علم الأئمّة عليهم السلام بالغيب والاعتراض عليه بالإلقاء للنفس إلى التهلكة والإجابات عنه عبر التاريخ والدفاع عن الكافي الشريف للإمام الكليني على ما ورد فيه من أحاديث الباب
السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي
تتطرّق هذه المقالة من خلال مفاد مفهوم روايات الكافي في مجال علم الأئمّة عليهم السلام بالغيب، إلى دراسة وتوضيح كيفية العلم الغيبي للأئمّة عليهم السلام.
ثمّ طرح الاعتراضات الواردة على هذه المسألة وعلى الشيخ الكليني على طول التاريخ وإلى يومنا هذا، والإجابة عنها بالدليل القاطع والبرهان الواضح.
أحصى المؤلّف أوّلاً أنواع الإشكالات المطروحة بهذا الشأن، ثمّ أجاب عنها مستعيناً بالطرق العقلية والبراهين المُستقاة من الحديث والقرآن.
من تلك الاعتراضات: إنّ علم الغيب هو من اختصاص اللّٰه تعالى، وذلك بشهادة القرآن، حيث يشير المؤلّف إلى سبعة آيات من القرآن الكريم في هذا المجال، والإجابة على شبهة المنتقدين فيها.
والاعتراض الثاني المطروح في هذه المسألة والذي يحظى بتأكيد المؤلّف، هو أنّ الرسول والإمام إذا كانا يعلمان الغيب، فلا بدّ أن يعرفا ما يضرّهما ويسوءهما، والعقل
ص: 29
والشرع يحكمان بوجوب الاجتناب والابتعاد عمّا يسوء ويضرّ، وإلّا كانا مصداق من ألقى بنفسه إلى التهلكة.
ويقوم بطرح الأمثلة في هذه لمسألة، وبالخصوص شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وتصنيف الاعتراضات حولها و ويشرع بكلّ سعة صدر بالردّ على هذه الشبهة بالأدلّة العقلية والنقلية، والدفاع عن ساحة الشيخ الكليني وكتاب أُصول الكافي.
ص: 30
الحمد للّٰه ربّ العالمين، الّذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وتُرفع الدرجات، وأفضل السلام وأكمل الصلاة على سيّد الكائنات، وأشرف الموجودات، محمّدٍ صاحب المعجزات الباهرات، وعلى الأئمّة المعصومين من آله ذوي الكرامات، والحجج البيّنات.
وبعدُ: فإنّ الإسلام يمرُّ في هذه الأيّام بظروفٍ صعبةٍ إذ استهدف الكفّار والملحدون قرآنه، وكرامته، وسنّته، وأولياءه، وأُمّته، بأنواعٍ من التزييف والتهجين والقذف والهتك والاتّهام؛ لتشويه سمعته وصورته بين شعوب العالم، ولزعزعة الإيمان به من قلوب معتنقيه والحاملين لاسمه، خصوصاً من ذوي المعلومات السطحيّة، والدراسة القليلة، والاطّلاع المحدود، ومن المغفّلين عن حقائق العلم والدين.
وقد استخدم أعداء الإسلام أحدث الأساليب والأجهزة والأدوات لتفعيلها في هذا الغرض الخبيث، ومن تلك الأساليب بعث المنبوذين ممّن لجأ إلى أحضان أعداء الإسلام، وتعمّم باليأس والقنوط من أن يصل إلى منصبٍ أو مقامٍ بين أُمّة الإسلام، وتعهّدوا له أن ينفخوا في جلده، ويكبّروا رأسه، ويصفوه بما يشتهي ويشتهون، ويقدّموه وكتاباته إلى أُمّة الإسلام وقد ملأها بالهُراء والسفسطة والكتابة الهزيلة الزائفة ضدّ عقائد الأُمّة وشريعتها ومصادر فكر الإسلام ومقدّساته، باسم الإصلاح، وباسم نقد العقل، وباسم الصياغة الجديدة، وباسم الإعادة لدراسة المعرفة، وباسم التصحيح، وباسم القراءة الجديدة! مع أنّ كلّ هذه الأسماء هي لمسمّىً واحدٍ هو:
«تشويه الإسلام وإراءة صورةٍ تشكيكيّةٍ لفكره وشريعته ومصادره»، وبأقلامٍ مأجورة وعقولٍ قاصرة عن درك أبسط المعاني سوى التلاعب بالألفاظ، وتسطير
ص: 31
المصطلحات من دون وضعها في مواضعها، بل باستخدامها في خلاف مقاصدها.
إنّ الاستعمار البغيض وأيديه العميلة، يتصوّرون أنّ بإمكانهم زعزعة الإيمان بالإسلام من قلوب الأُمّة الإسلاميّة، الّتي فتحت عيونها في هذا القرن على كلّ ألاعيب الأعداء وأساليب عملهم، وخاصّة باستخدام هذه العناصر البغيضة.
وبعد انتصار الثورة الإسلاميّة المجيدة بقيادة الإمام المجاهد، العلم الرائد السيّد الخميني رحمه الله، توجّه الاستعمار البغيض وعملاؤه الحقراء، إلى مقاومة التشيّع وأُصوله وفروعه وتراثه المجيد؛ لأنّه المذهب الوحيد بين المذاهب الإسلاميّة الّذي أنجز الوعد الإلٰهي للمستضعفين في الأرض، وتمكّن بدحر الكفر والنفاق بأوليائه من تمكينهم فيها، بإقامة دولةٍ على أساس الإسلام، ولا يزال يقوم بدور الريادة للقيادة إلى الانتصار الأكبر.
ومنذ اندلاع الثورة الظافرة وبعد انتصارها وحتّى اليوم، بدأت الاتّهامات تُترى إلى هذا المذهب العظيم مذهب أهل بيت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، بشتّى الصور والأشكال، وبكلّ الأدوات والرسائل، حتّى شنّ الحرب الضروس على يد العميل الناصبي الوغد المتحكّم على العراق.
وكان من أساليبهم القذرة بعث وعّاظ السلاطين وعلماء البلاط على تزييف التراث الشيعيّ في مختلف علومه ومعارفه، وبخاصّةٍ التراث الحديثي الّذي يعتبر أوسع كنزٍ للثقافة والمعرفة الحقّة.
فاستهدفوا - فيما استهدفوا - أهمّ كتب الحديث وأقدمها وأكبرها حجماً وأعظمها قدراً، ألا وهو كتاب الكافي الشريف للإمام أبي جعفر الكليني، محمّد بن يعقوب الرازي (ت 329 ه)، فوجّهوا رأس الحربة إليه، وجعلوه غرضاً لسهام النقد المسمومة.
وممّا أثاروه وأكثروا اللغط والتشويش عليه، هو موضوع: «علم الأئمّة عليهم السلام بالغيب»، كما يلتزمه الشيعة، بما لم تتحمّله عقول أعدائهم الناقدين؛ لأنّهم لم يفهموا أدلّته،
ص: 32
ولم يعوا مداهُ ولا مغزاه، فانهالوا عليه بالنقد والتزييف والتهريج والتهويل، زاعمين أنّ في ذلك «غُلوّاً»، وأنّه يحتوي على دعوى «علمهم المطلق بالغيب»، وهو لا يعلمه إلّااللّٰه.
ناظرين إلى ظواهر عناوين أثبتها الإمام الكليني في كتاب الكافي، بينما الإمام الكليني إنّما أثبت ما في تلك العناوين من خلال نصوص القرآن الكريم قبل كلّ شيءٍ ، ثمّ ما أعلنه الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم لأهل بيته، ثمّ ما أظهره الأئمّة عليهم السلام لأنفسهم ممّا وافق القرآن الكريم، ووافق الحديث الشريف الموثوق المجمع عليه، ولم يخالف العقل ولا المنطق السليم.
وكلّ هذا واضح من عناوينٍ الأبواب الّتي وضعها الكليني فيما يرتبط بعلم الأئمّة عليهم السلام ممّا سنعرضها هنا، مأخوذة من كتاب «الحجّة» من الكافي، وهي:
1 - باب أنّ أهل الذكر، الّذين أمر اللّٰه الخلق بسؤالهم: هم الأئمّة عليهم السلام.
2 - باب أنّ من وصفه اللّٰه تعالى في كتابه بالعلم: هم الأئمّة عليهم السلام.
3 - باب أنّ الراسخين في العلم: هم الأئمّة عليهم السلام.
4 - باب أنّ الأئمّة عليهم السلام قد أُوتوا العلم وأُثبت في صدورهم.
5 - باب أنّ من اصطفاه اللّٰه من عباده وأورثهم كتابه: هم الأئمّة عليهم السلام.
وهذه الأبواب الخمسة تحتوي على ما يفسّر آيات القرآن الكريم، وتنطبق على علم الأئمّة عليهم السلام من خلال الأحاديث الشريفة.
وبهذه البداية تردّ دعاوي الغلوّ عن كلّ ما فيها من المواضيع، حيث إنّ الكليني قدس سره بدأ بحثه عن علم الأئمّة عليهم السلام ممّا ثبت لهم من القرآن، واستلهم عن آياته، فكيف يُقال:
إنّ في إثباته لهم غلوّاً فيهم، وإفراطاً بالقول فيهم.
ثمّ انظر إلى الأبواب الآتية:
6 - باب أنّ الأئمّة عليهم السلام معدن العلم، وشجرة النبوّة، ومختلف الملائكة.
7 - باب أنّ الأئمّة عليهم السلام ورثة العلم، يرث بعضهم بعضاً العلم.
ص: 33
8 - باب أنّ الأئمّة عليهم السلام تورّثوا علم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وجميع الأنبياء والأوصياء الّذين من قبلهم.
9 - باب أنّ الأئمّة عليهم السلام عندهم جميع الكتب الّتي نزلت من عند اللّٰه عزّ وجلّ ، وأنّهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها.
10 - باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلّاالأئمّة عليهم السلام، وأنّهم يعلمون علمه كلّه.
11 - باب في أنّ الأئمّة عليهم السلام يزدادون في ليلة الجمعة.
12 - باب لولا أنّ الأئمّة عليهم السلام يزدادون لنفد ما عندهم.
13 - باب أنّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم الّتي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والأوصياء.
وهذه الأبواب فيها التأكيد على ارتباط علم الأئمّة عليهم السلام بالنبوّات والأنبياء، وخاصّة نبيّنا محمّد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم الّذي أخذ العلم من الوحي النازل عليه. وهذا ردّ على دعوى نسبة الغيب إليهم عليهم السلام بالاستقلال، ومن طرق غير طرق النبيّ الأعظم والأنبياء من قبل.
فالّذي جاء في هذه الأبواب هو: إنّ علم الأئمّة عليهم السلام مأخوذ من المعارف الإلهيّة الّتي أوحاها إلى الأنبياء، وكانت عند الملائكة والأوصياء وفي الكتب المنزلة الّتي يتوارثها الأئمّة، فهي ليست من الغيب الإلٰهي الخاصّ به تعالى، بل هم ممّا ارتضاهم لعلمه.
وبعد هذا، عنون الإمام الكليني للباب التالي:
14 - باب فيه ذكر الغيب.
حيث حدّد فيه «الغيب» وما يختصّ علمه باللّٰه تعالى واستأثر به لنفسه، ولم يتعدّ إلى غيره.
وبهذا ميّز الكليني بين ما سبق هذا الباب، وبين ما لحقه من الأبواب، فعرّف حقيقة الغيب، وما نفي علمه عن غير اللّٰه، وهو العلم الذاتي الاستقلالي، وفي نفس الوقت نبّه على أنّ ما أثبت للأئمّة عليهم السلام في الأبواب السابقة على هذا الباب (14)، كلّه خارج عن الغيب المذكور؛ لكونه كلّه علماً مستلهماً من القرآن، وموروثاً من الأنبياء
ص: 34
والأوصياء.
وكذلك نبّه إلى أنّ ما يأتي من الأبواب إنّما أُعطي لهم علمه لكونهم أولياء اللّٰه المخلصين الّذين اختصّهم اللّٰه للإمامة من بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وخلفاء له وأوصياء، وحججاً للّٰه على خلقه، خصّهم اللّٰه بذلك العلم لمقامهم هذا، كما خصّ الأنبياء والأوصياء السابقين، فانظر إلى العناوين التالية:
15 - باب أنّ الأئمّة عليهم السلام إذا شاؤوا أن يعلموا لعلموا.
16 - باب أنّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون، وأنّهم لا يموتون إلّاباختيارٍ منهم.
17 - باب أنّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون، وأنّه لايخفى عليهم الشيء صلوات اللّٰه عليهم.
18 - باب أنّ اللّٰه عزّ وجلّ لم يعلّم نبيّه علماً إلّاأمره أن يعلّمه أمير المؤمنين عليه السلام.
19 - باب جهات علوم الأئمّة عليهم السلام.
20 - باب أنّ الأئمّة عليهم السلام محدّثون مفهّمون.
21 - باب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الّذي كان قبله، عليهم السلام جميعاً.
فنرى في هذه الأبواب أنّ علم الأئمّة عليهم السلام محدّد بقيودٍ تخرجه عن كونه من علم الغيب المستقلّ الخاصّ بالبارئ تعالى:
ففي الباب (15): قيّد العلم بقيد «إذا شاؤوا...» فهو إذن ليس قبل المشيئة لدُنّيّاً مستقرّاً.
وفي الباب (16): تعلّق علمهم بموتهم، فكيف يكون هذا غلوّاً فيهم ؟!
وفي الباب (17): وسّع دائرة علمهم إلى ما كان وما يكون، ولو كان من علم الغيب لم يحتج إلى هذه التوسعة.
وفي الباب (18): تصريح بأنّ علم الإمام إنّما هو من اللّٰه تعالى بواسطة نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم.
وفي الباب (19): أثبت لعلمهم جهاتٍ ، بينما العلم اللدنّي لايختصّ بجهة دون جهة!
ص: 35
وفي الباب (20): أثبت أنّهم يأتيهم الحديث والفهم من خارج! فليس لدُنّيّاً ذاتيّاً مستقلاًّ.
وفي الباب (21): حدّد لعلمهم وقتاً، واللدنّيُّ غير مؤقّت.
وهكذا ترى أنّ الإمام الكليني إنّما أثبت في كتاب الكافي الشريف ما ليس فيه أدنى شبهة للغُلوّ أو شمول علم الأئمّة عليهم السلام للغيب اللدنّي الّذي هو خاصّ باللّٰه تعالى، وهو العلم المطلق والمستقلّ ، وإذا اختارهم اللّٰه لبعض علمه، فلأنّهم ممّن ارتضاهم في قوله: «إِلاّٰ مَنِ اِرْتَضىٰ مِنْ رَسُولٍ » ، وهو موروث من جدّهم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.
ومثل هذا العلم ليس ممّا يستكثر عليهم، ولا ممّا يستنكر وجوده عندهم، ولا يتفوّه بإنكاره عليهم من يؤمن باللّٰه وكتابه وبرسوله وبما أنزل من كتاب وسنّة في حقّ خلفائه الأئمّة عليهم السلام، ولكنّ الّذين لم يستضيؤوا بنور العلم، ولم يستندوا في أخذه إلى ركنٍ ركينٍ وثيقٍ ، حاولوا الاستنكار؛ لأنّهم حشويّة لا يفهمون الكلام المتعارف؛ لأنّهم سطحيّون ظواهريّون! لا يقارنون بين المقولات، ولا يدركون ما وراء الألفاظ من المعقولات أو الدلالات والملازمات، فهم يحكمون على النصوص بظواهرها، وليس لديهم من فقه الحديث وقواعده علمٌ ولا خبرةٌ .
وقد أصبح هؤلاء - وبهذه العقليّة البسيطة والمنحرفة عن أهل البيت وأئمّتهم عليهم السلام - راحوا يبحثون في التراث الشيعيّ العظيم؛ كي يقفوا على ما يحتجّون به للردّ على الشيعة والتشيّع، فلمّا وقفوا على تلك الأبواب، وبالأخصّ على مثل الباب (16)! اتّخذوه ذريعةً للتهريج والتهويل والتطبيل والتكفير والتفسيق للشيعة وإبطال الحقّ .
ثمّ إنّهم استهووا بعض الزعانف من الجهلة، وأوحوا إليهم الشبهة في علم الأئمّة عليهم السلام: إنّهم إذا كانوا يعلمون متى يموتون، وأنّ موتهم إذا كان باختيارهم، فلماذا أقدموا على ما جرى عليهم ؟ أليس ذلك إلقاءً لأنفسهم في التهلكة الّتي نهى عنها اللّٰه بقوله: «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ » ؟
وبما أنّ هذه الشبهة مثارةٌ من قديم الأيّام، ومنذ عصور الأئمّة عليهم السلام، فرأينا أن ننشر
ص: 36
هذا البحث ليكون مبيّناً لحقيقة الأمر، وردّاً حاسماً على مزاعم الزيف الواردة في تلك الكتابات. وهو يستوعب العناوين التالية:
* أصل المشكلة.
* تحديد محاور البحث العامّة وعلم الغيب.
* صيغ الاعتراض عبر التاريخ:
1 - في عصر الإمام الرضا عليه السلام (ت 203 ه).
2 - في عصر الكليني رحمه الله (ت 329 ه). وفيه الجواب عن الاعتراضات على الكافي.
3 - في عصر الشيخ المفيد رحمه الله (ت 413 ه).
4 - في عصر الشيخ الطوسي رحمه الله (ت 460 ه).
5 - في عصر الشيخ ابن شهر آشوب رحمه الله (ت 588 ه).
6 - في عصر الشيخ العلّامة الحلّي رحمه الله (ت 726 ه).
7 - في عصر الشيخ المجلسي رحمه الله (ت 1110 ه).
8 - في عصر الشيخ البحراني رحمه الله (ت 1186 ه).
9 - مع السيّد الخراساني رحمه الله في القرن السابق (ت 1368 ه).
10 - في هذا القرن.
* خلاصة البحث.
والمرجوّ من اللّٰه أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاه، وأن يفيض علينا من فضله وبرّه وإحسانه، إنّه كريم وهّاب وهو ذو الجلال والإكرام.
الإمامة هي خلافة عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في أداء المهامّ الّتي كانت على الرسول، فلا بدّ أن يتميّز الإمام بكلّ ما يمكن من مميّزات الرسول، من العصمة، والعلم، والكمال، وسائر الصفات الحميدة، وأن يتنزّه عن كلّ الصفات الذميمة والمشينة.
وقيد «ما يمكن» هو لإخراج ميزة «الرسالة والنبوّة»، فإنّها خاصّة بالرسول
ص: 37
المصطفى، والمبعوث بها من اللّٰه، والمختار لهذا المقام العظيم، لقيام الأدلّة - كتاباً وسنّة - على أنّه صلى الله عليه و آله و سلم خاتم النبيّين، وأنّه لا نبيّ بعده.
وقد أشبع علماء الكلام - في كتبهم - البحث والاستدلال على ما ذكرناه جملةً وتفصيلاً، بما لا مزيد عليه.
وفي صفة «العلم» التزم الشيعة الإماميّة بأنّ النبيّ لا بدّ أن يكون عالماً بكلّ ما تحتاج إليه الأُمّة؛ لأنّ الجهل نقصٌ ، ولا بدّ في النبيّ أن يكون أكمل الرعيّة حتّى يستحقّ الانقياد له واتّباع أثره وأن يكون أُسوةً .
وكذا الإمام، لا بدّ أن يكون عالماً - بنحو ذلك - حتّى يستحقّ الخلافة عن النبيّ في الانقياد له واتّباع أثره ولكي يكون أُسوةً .
وبعد التسليم بهذا، وقع البحث في دائرة «العلم الّذي يجب أن يتّصف به النبيّ والإمام»، هل هو العلم بالأحكام فقط؟ أو يعمّ العلم بالموضوعات الأُخرى وسائر الحوادث الكونيّة، بما في ذلك المغيّبات الماضية والمستقبلة ؟
فالتزم الإماميّة بإمكان هذا العلم بنحوٍ مطلق، وعدم تخصيصه أو تقييده بشيءٍ دون آخر من المعلومات، في أنفسها، إلّاما دلّت الأدلّة القطعيّة على إخراجه.
واعتُرض على هذا الالتزام بوجهين:
وقوله تعالى: «وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ اَلْغَيْبِ لاٰ يَعْلَمُهٰا إِلاّٰ هُوَ»(1) .
وقد وصف اللّٰه نفسه جلّ ذكره بأنّه «عالمُ الغَيْبِ » في آيات أُخرى:
منها قوله تعالى: «عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ وَ هُوَ اَلْحَكِيمُ اَلْخَبِيرُ»(2) .
وقوله تعالى: «ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلىٰ عٰالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ »(3) .
وقوله تعالى: «عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ اَلْكَبِيرُ اَلْمُتَعٰالِ »(4) .
وقوله تعالى: «عٰالِمُ اَلْغَيْبِ فَلاٰ يُظْهِرُ عَلىٰ غَيْبِهِ أَحَداً»(5) .
إنّ الرسول والإمام إذا كانا يعلمان الغيب، فلا بدّ أن يعرفا ما يضرّهما ويسوؤهما، والعقل والشرع يحكمان بوجوب الاجتناب والابتعاد عمّا يسوء ويضرُّ، بينما نجد وقوع النبيّ والإمام فيما ضرّهما وآذاهما.
وقد جاء التصريح بهذه الحقيقة على لسان النبيّ في قوله تعالى: «وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ اَلْخَيْرِ وَ مٰا مَسَّنِيَ اَلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاّٰ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ »(6) ، ولو كان الأئمّة يعلمون الغيب، لما أقدموا على أعمالٍ أدّت إلى قتلهم وموتهم، وورود السوء عليهم، كما أقدم أمير المؤمنين عليه السلام على الذهاب إلى المسجد ليلة ضربه ابن ملجم، فمات من ضربته، وكما أقدم الحسين عليه السلام على المسير إلى كربلاء، حيث قُتل وسبُيت نساؤه وانتُهب رحلُه.
فإنّ كلّ ذلك لو كان مع العلم به، لكان من أوضح مصاديق الإلقاء للنفس في
ص: 39
التهلكة، الّذي نهى عنه اللّٰه في قوله تعالى: «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اَللّٰهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ »(1) .
وقد أُثير هذا الاعتراض الثاني قديماً جدّاً، حتّى أنّا نجده معروضاً على الأئمّة عليهم السلام أنفسهم، ونجده مطروحاً في القرون التالية مكرّراً، كما قد تعدّدت الإجابات عنه كذلك عبر القرون.
وقد حاولنا في هذا البحث أن نسرد الاعتراض بصيغه المختلفة، وحسب تواريخها المتوالية، مع ذكر الإجابات عنه كذلك.
إنّ الاعتراض الثاني إنّما يُفرض ويكون وارداً وقابلاً للطرح والمناقشة، فيما إذا التزم بالفراغ عن الاعتراض الأوّل، وكان المعترض بالثاني ملتزماً بأنّ الرسول والإمام يعلمان الغيب، ليفرض كون إقدامهما على موارد الخطر إلقاءً للنفس في التهلكة.
وإلّا، فإن لم يقل المعترض بأنّهما يعلمان الغيب، فإنّ الإقدام لا محذور فيه، وليس من الإلقاء في التهلكة؛ لأنّ غير العالم بالخطر معذورٌ في الإقدام عليه، فنفس إيراد الاعتراض الثاني، وفرض وروده يلازم ثبوت التزام المعترض بفكرة العلم بالغيب لدى النبيّ والإمام، خصوصاً مع عدم المناقشة بالاعتراض الأوّل، كما هو المفروض في صيغ الاعتراض الثاني منذ عصور الأئمّة عليهم السلام.
وهذا يدلّ على أنّ فكرة «علم الأئمّة بالغيب» مفروضةٌ عند السائلين، ولا اعتراض لهم عليها، وإنّما أرادوا الخروج من الاعتراض الثاني فقط، أو على الأقلّ
ص: 40
فرض التسليم به والاعتراف به ولو جدلاً، حتّى يكون فرض الاعتراض الثاني ممكناً، وإلّا، لكان اللّازم ذكر الاعتراض الأوّل، الّذي بتماميّته ينتفي اعتقاد «علم الغيب»، وبذلك لا يبقي للاعتراض الثاني مجالٌ .
ويظهر من الإجابات المذكورة الّتي تحاول توجيه مسألة الإقدام على ما ظاهره الخطورة والتهلكة، هو الموافقة على أصل فكرة علم الأئمّة بالغيب، وعدم إنكار فرضه على السائلين، ومن المعلوم أنّ التوجيه إنّما يُلجأ إليه عندما يكون أصل السؤال مقبولاً وغير منكر، وإلّا فإنّ الأولى في الجواب هو نفي الأصل وإنكاره وعدم الموافقة على فرض السؤال صحيحاً. وهذا الأمر واضح في المحاورات والمباحثات.
إنّ الإمامة إذا ثبتت لأحدٍ، فلا بدّ أن تتوفّر فيه شروطها الأساسيّة، ومن شروطها عند الشيعة الإماميّة: «العصمة»، وهي تعني الامتناع عن الذنوب والمعاصي بالاختيار.
ومنها العلم بالأحكام الشرعيّة تفصيلاً، فمن صحّت إمامته واستجمع شرائطها، لم يتصوّر في حقّه أن يُقدم على محرّم كإلقاء النفس في التهلكة، المنهيّ عنه في الآية.
وحينئذٍ لا بدّ أن يكون ما يصدر منه مشروعاً، فلا يمكن الاستناد إلى «حرمة الإلقاء في التهلكة» لنفي علم الغيب عنه؛ لأنّ البحث عن علمه بالغيب إنّما يكون بعد قبول إمامته، وهي تنفي عنه الإقدام على الحرام.
وهذا يعني أنّ ما يُقدم عليه هو حلالٌ مشروعٌ ، سواء علم الغيب أم لم يعلمه، فلا يمكن نفي علمه بالغيب بفرض حرمة الإلقاء في التهلكة عليه.
ومن هنا توصّلنا إلى أنّ الاعتراض الثاني - وهو «أداء الالتزام بعلم الأئمّة للغيب إلى إلقائهم بأيديهم إلى التهلكة» - اعتراض لا يصدر ممّن يعتقد بإمامة الأئمّة الاثني
ص: 41
عشر عليهم السلام، ويلتزم بشرائط الإمامة الحقّة المسلّمة الثبوت في كتب الكلام والإمامة.
وما يوجد من صور الاعتراض في تراثنا العلميّ إنّما هو افتراض بغرض دفع شُبه المخالفين، وردّ اعتراضاتهم.
إنّ بعض أدعياء العقل ونقده، قد انبرىٰ للتطفّل على الكتب والكتابة، وعلى التراث ومصادره القديمة، بادّعاء الإعادة لقراءتها، فعرض هذا البحث بصورة مشوّهة تنمّ عن جهلٍ بأوّليات المعرفة الإسلاميّة، وقصورٍ عن فهم أبسط نصوصه، وعرض مشبوهٍ لها، لإقدامه على بتر المتون، واقتصاره على الجمل والعبارات الّتي توحي بغرضه على حدّ زعمه، مع ارتباكٍ في العرض واضطرابٍ في البحث واستخدامٍ لأُسلوب القذف والسبّ ! وليس كلّ هذا - ولا بعضه - من شأن طالب للعلم، فضلاً عمّن يدّعي العقل ونقده، والمعرفة وإعادتها!
ومن الخبط الجمع بين الالتزام بالاعتراضين في عرضٍ واحدٍ وبصورةٍ متزامنةٍ ، فإنّ من غير المعقول أن يحاول أحدٌ أن ينفي عن الأئمّة علم الغيب، زاعماً منافاة ذلك للعقل؛ وهو يحاول الاستدلال بالآيات الكريمة الّتي ذكرنا بعضها في صدر هذا البحث، غافلاً عن أنّ دلالة هذه الآيات على اختصاص علم الغيب بذات اللّٰه تعالى، مسلّمةٌ عند جميع المسلمين، شيعة وأهل سنّة، ولم يختلف في ذلك اثنان، وليس موضع بحثٍ وجدلٍ حتّى يحتاج إلى إثباتٍ ونقاشٍ ، ولم يدّع أحدٌ أنّ غير اللّٰه تعالى يمكنه بصورةٍ مستقلّةٍ العلم بالغيب.
وإنّما يقول الشيعة بأنّ اللّٰه تعالى أوحى إلى نبيّه من أنباء الغيب، وقد أخبر عن ذلك في قوله تعالى: «ذٰلِكَ مِنْ أَنْبٰاءِ اَلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ...»(1) .
وقد استثنى اللّٰه الرسول ممّن لا يظهر على الغيب، فقال تعالى: «عٰالِمُ اَلْغَيْبِ فَلاٰ
ص: 42
يُظْهِرُ عَلىٰ غَيْبِهِ أَحَداً * إِلاّٰ مَنِ اِرْتَضىٰ مِنْ رَسُولٍ ...»(1) .
فبالإمكان إذن ظهور الغيب الإلٰهيّ على غير اللّٰه تعالى، لكن بإذنه تعالى وبوحيه وإلهامه.
وقد ثبت بطرقٍ مستفيضةٍ أنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أخبر عليّاً وأهل البيت عليهم السلام بذلك، وقد توارثه الأئمّة عليهم السلام، فهو مخزونٌ عندهم.
وقد عنون الشيخ المفيد رحمه الله لبابٍ في كتاب أوائل المقالات، نصّه: «القول في علم الأئمّة عليهم السلام بالضمائر والكائنات، وإطلاق القول عليهم بعلم الغيب، وكون ذلك لهم في الصفات»، قال فيه:
وأقول: إنّ الأئمّة من آل محمّدٍ صلى الله عليه و آله و سلم قد كانوا يعرفون ضمائربعض العباد، ويعرفون ما يكون قبل كونه.
وليس ذلك بواجبٍ في صفاتهم، ولا شرطاً في إمامتهم، وإنّما أكرمهم اللّٰه تعالى به، وأعلمهم إيّاه للطفٍ في طاعتهم والتمسّك بإمامتهم. وليس ذلك بواجبٍ عقلاً، ولكنّه وجب لهم من جهة السماع.
فإمّا إطلاق القول عليهم بأنّهم يعلمون الغيب! فهو منكرٌ بيّن الفساد؛ لأنّ الوصف بذلك إنّما يستحقُّه من علم الأشياء بنفسه لا بعلمٍ مستفادٍ، وهذا لا يكون إلّا للّٰه عزّ وجلّ .
وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة، إلّامن شذّ عنهم من المفوّضة، ومن انتمى إليهم من الغُلاة(2).
وقد أثبت الشيخ المفيد الروايات المنقولة بالسمع والدالّة على علم الأئمّة عليهم السلام بالمغيّبات - والّتي هي دلائل على فضلهم واستحقاقهم للتقديم - في كتاب الإرشاد في أحوال كلّ إمامٍ ، فليراجع.
ص: 43
فنسبة القول بأنّ : الأئمّة يعلمون الغيب بالإطلاق إلى الشيعة، من دون تفسيرٍ وتوضيحٍ بأنّه بتعليم الرسول الآخذ له من الوحي، أو بالإلهام والإيحاء والقذف في القلب من اللّٰه، وبالنظر بنور اللّٰه، كما جاء في الخبر عن المؤمن أنّه: «ينظر بنوره تعالى»، فهي نسبةٌ ظالمةٌ باطلةٌ ، يُقصد بها تشويه سمعة هذه الطائفة المؤمنة الّتي أجمعت على اختصاص العلم الذاتيّ للغيب باللّٰه تعالى، تبعاً لدلالة الآيات الكريمة، وإنّما التزمت أيضاً بما دلّت عليها الآيات الأُخرى من إيصال ذلك العلم إلى الرسول، وما دلّت عليه الآثار والأخبار من وصول ذلك العلم إلى الائمّة عليهم السلام.
فلم يكن في تلك النسبة الظالمة إلّاالتقوّل على الشيعة، مضافاً إلى كشفها عن الجهل بأفكار الطائفة وعقائدها ومبادئها.
فكيف يحقّ لمثل هذا المغرض المتقوّل أن يتدخّل في إعادة قراءة التراث الشيعي ؟! ومع أنّه التزم بنفي علم الغيب عن الرسول والأئمّة عليهم السلام، فهو يحاول أن يورد الاعتراض الثاني أيضاً في عرض الاعتراض الأوّل، بأنّ في أفعال الرسول والأئمّة ما هو من الإلقاء في الهلكة، وفيما أصابهم على أثر إقدامهم كثيرٌ من السوء الّذي وقعوا فيه، وحاول جمع ما يدلّ على ذلك ممّا أصاب الرسول وأهل البيت طول حياتهم، مؤكّداً على أنّ ذلك هو من «السوء» ومن «الهلكة».
مع أنّ من الواضح - بعد إصراره على نفي علم الغيب عنهم - أنّ عملهم لم يكن إقداماً منهم على الهلكة، فيجب أن لا يحاسبوا على الإقدام عليها، أو ينهوا عن الإلقاء فيها؛ لأنّ الجاهل بالشيء لا يحاسب عليه، ولا يكلّف بالاجتناب عنه ودفعه.
إنّ تسمية الفعل الّذي يقدم عليه الفاعل المختار سوءاً أو هلكةً ، إنّما يتبع المفسدة الموجودة في ذلك الفعل، فإذا خلا الفعل في نظر فاعله عن المفسدة، أو ترتّبت عليها مصلحةٌ أقوى وأهمّ من المفسدة، ولو في نظره، لم يُسمّ سوءً ولا هلكةً .
ص: 44
فليس لهذه العناوين واقعاً ثابتاً حتّى يقال: إنّ ما أقدم عليه الأئمّة هو سوء وهلكة، بل هي أُمور نسبيّة تتبع الأهداف والأغراض والنيّات، بل يُراعى في تسميتها الغرض، فربّ نفعٍ في وقتٍ هو ضررٌ في آخر، ورُبّ ضررٍ لشخصٍ هو نفعٌ لآخر.
قال تعالى: «وَ عَسىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَ عَسىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ »(1) .
وقال تعالى: «فَعَسىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اَللّٰهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً»(2) .
هذا في المنظور الدنيوي المادّي، وأمّا في المنظار الإلٰهي والمثالي وعالم المعنويّات، فالأمر أوضح من أن يُذكر أو يُكرّر.
فهؤلاء الأبطال الّذين يقتحمون الأهوال، ويُسجّلون البُطولات في سبيل أداء واجباتهم الدينيّة والعقيديّة أو الوطنيّة والوجدانيّة أو الشرف، إنّما يُقدمون على ما فيه فخرُهم، مع أنّهم يحتضنون «الموت» ويعتنقون «الفناء»، لكنّه في نظرهم هو «الحياة» و «البقاء».
كما أنّ المجتمعات تُمجّد بأبطالها وتُخلّد أسماءهم وذكرياتهم؛ لكونهم المضحّين من أجل الأهداف السامية، وليس هناك من يُسمّي ذلك «هلاكاً» أو «سوءاً»، إلّاالساقط عن الصُعُود إلى مُستوى الإدراك، وفاقد الضمير والوجدان من المنبوذين.
دون الّذين استبسلوا في ميادين الجهاد في الحروب والنضالات الدامية، الساخنة أو الباردة، ومن أجل إعلاء كلمة اللّٰه في الأرض، أُولئك الّذين قال عنهم اللّٰه إنّهم:
«... أَحْيٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمٰا آتٰاهُمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّٰ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اَللّٰهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اَللّٰهَ
ص: 45
لاٰ يُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُؤْمِنِينَ »(1) ، هؤلاء الّذين «قُتلُوا» في سبيل اللّٰه.
ولا بدّ أنّ الشهداء قد قصدوا الشهادة وطلبوها وأرادوها، إذ لا يُسمّى من لا يُريدها «شهيداً»، وهيهات أن يُعطاها من يفرّ منها، مهما كان مظلوماً، وكان قتلُه بغير حقٍّ .
إنّ المسلم إذا اقتحم ميداناً بهدف إحقاق الحقّ أو إبطال الباطل، ثمّ أصابه ما لا يُتحمّل إلّافي سبيل اللّٰه، أو أدركه القتل وهو قاصدٌ للتضحية، فإنّ ذلك ليس سوءاً ولا شرّاً، بل هو خيرٌ وبرٌّ، بل هو فوق كلّ برٍّ، وليس فوقه برٌّ، كما نطق به الحديث الشريف عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ فوق كلّ بِرٍّ بِرٌّ حتّى يُقتل الرجل في سبيل اللّٰه».
فلا يدخل مثل هذا في «التهلكة» الّتي نهى اللّٰه عنها في الآية، بل هو من «الإحسان» الّذي أمر اللّٰه به في ذيل تلك الآية فقال تعالى: «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ ، وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اَللّٰهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ »(2) .
والشهادة هي إحدى الحُسنيين - النصر أو الشهادة - في قوله تعالى: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنٰا إِلاّٰ إِحْدَى اَلْحُسْنَيَيْنِ ...»(3) .
وإذا لم يصحّ إطلاق «السوء» على ما أصاب النبيّ والإمام من البلاء في سبيل اللّٰه، وعلى طريق الرسالة والإمامة، ومن أجل إعلاء كلمة اللّٰه، والدفاع عن الحقّ ودحر الباطل، فالاستدلال بقوله تعالى: «قُلْ لاٰ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا إِلاّٰ مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ اَلْخَيْرِ وَ مٰا مَسَّنِيَ اَلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاّٰ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ »(4) ، على نفي علم الغيب عن الرسول، وإثبات أنّ السوء يمسّه فهو لايعلم به؛ ليس استدلالاً صحيحاً، لفرض أنّ ما أصاب الرسول - وكذا الأئمّة - في مجال الدعوة والرسالة الإسلاميّة وأداء المهامّ الدينيّة، لا يعبّر عنه بالسوء، كما أوضحناه.
ص: 46
فبما أنّ «لو» حرف امتناع، فهي تدلّ على أنّ امتناع كونه عالماً بالغيب أدّى إلى امتناع استكثاره من الخير، وامتناع أن لم يمسّه السوء، وذلك قبل اتّصال الوحي به، فغاية ما يدلّ عليه ظاهر الآية أنّه كان بالإمكان أن يمسّه السوء، ولم تدلّ الآية على أنّه فعلاً - وبعد نزول الوحي، وفي المستقبل - لم يعلم الغيب، ولم يستكثر من الخير، وسوف يمسّه السوء.
فظاهر الآية أنّ الامتناعين كانا في الماضي؛ لكون الأفعال مستعملةً بصيغة الماضي، وهي: «كنتُ » و «استكثرتُ » و «ما مسّني»، فهو تعبيرٌ عن إمكان ذلك في الماضي لعدم علمه بالغيب سابقاً، لا على وقوع ذلك، ولا على عدم علمه به مستقبلاً، أو امتناع حصول الغيب له في المستقبل وبعد اتّصاله بالوحي، فلا ينافي ذلك أن يكون في المستقبل «يعلم بالغيب» من خلال الوحي طبعاً، وأنّه «يستكثر من الخير» وأنّه «لا يمسّه السوء».
كما دلّت آيات أُخرى على حصول الأفعال له. فقال تعالى: «ذٰلِكَ مِنْ أَنْبٰاءِ اَلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ...»(1) ، وقال تعالى: «إِنّٰا أَعْطَيْنٰاكَ اَلْكَوْثَرَ»(2) ، وقال تعالى: «كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ اَلسُّوءَ وَ اَلْفَحْشٰاءَ ...»(3) .
مع أنّ ذيل الآية - المستدلّ بها - وهو قوله تعالى: «... إِنْ أَنَا إِلاّٰ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » يدلّ على المراد من صدرها، فإنّ مهمّة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم منحصرة بالإنذار والتبشير، وإنّما خصّصهما «لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » ؛ لاعترافهم وقناعتهم بالنبوّة، وإيمانهم بأنباء الغيب الّذي يأتي به وينذر به ويبشّر به، بينما غير المؤمنين، لا يقتنعون بهذا الغيب، فماذا يريد النبيّ نفيه من الغيب في صدر الآية ؟!
ص: 47
إنّه ينفي عن نفسه العلم بالغيب الّذي طلبوا معرفته منه بالاستقلال وبلا وحي، معرفةً ذاتيةّ لدُنّية، فإنّهم كانوا يطالبونه بالإخبار عن علم الساعة، كأسئلة امتحانية يريدون إبكات النبيّ وإفحامه بها، كما صرّحت بذلك الآية السابقة على هذه والمرقّمة (187) من سوره الأعراف، فكان النفي وارداً على «علم الغيب بالساعة» ومن غير الوحي، ولا من خلال الرسالة، ومن دون أن تتعلّق مشيئة اللّٰه أن يعلّمه نبيّه، وإلّا، فنفس النبوّة والإنذار والتبشير، هي من الغيب الّذي جاء به، ومدح المؤمنين بأنّهم «يؤمنون بالغيب».
فلو دلّ على عدم إخبار نبيّه به ممّا اختصّ اللّٰه علمه بنفسه، كأمر الروح وعلم الساعة وما نُصّ - من الأُمور - على أنّ علمها عند اللّٰه، فهو من العلم المكنون الخاصّ باللّٰه تعالى، وأمّا أُمور ممّا قامت الآثار والأخبار على أنّ النبيّ والأئمّة عليهم السلام كانوا على علمٍ بها، من خلال الوحي وإخباره، وجبرئيل ونزوله، والكتب السماوية وأنبائها، فليس في الالتزام بذلك تحدّياً لاختصاص علم الغيب باللّٰه جلّ ذكره، وليس ذلك منافياً لكتابٍ أو سنّةٍ ، أو أصلٍ ثابتٍ ، أو فرعٍ ملتزمٍ به.
ومن جميع ما ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال على نفي علم الغيب عن الرسول والإمام، بمحدوديّة وجودهما الّذي هو من الممكنات وعدم أزليّتها وعدم أبديّتها، مع أنّ الغيب لا حدود له، والمحدود لا يستوعب غير المحدود بحكم العقل، ولذلك اختصّ «علم الغيب» باللّٰه تعالى الّذي لا يحدّ؛ وذلك لأنّ محدوديّة النبيّ والإمام أمرٌ لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، وكذلك اختصاص علم الغيب باللّٰه أمرٌ قد أثبتناه، ولم ينكره أحدٌ من المسلمين، كما ذكرناه.
لكنّ المدّعىٰ أنّ اللّٰه تعالى أكرمهم وخصّهم بأنباءٍ من الغيب ووهبهم علمها، فبإذنه وأمره علموا ذلك، وأصبح ذلك لهم «شُهوداً»، وإن كان لغيرهم «غيباً»
ص: 48
محجوباً. وإنّما اختصّهم اللّٰه بذلك؛ لقُربهم منه بالعمل الصالح والنيّة الصادقة، وإحراز الإخلاص والتقوى منهم، والجدّ في البذل والفداء عندهم.
ولم يُعطوا ذلك بالجبر والإكراه، بل من جهة امتلاكهم للسمات المؤهّلة للوصول إلى الدرجات، واستحقاق المقامات الّتي أثبتتها لهم الفتنة والابتلاء والامتحان، والمعاناة الطويلة الّتي قاسوها في مختلف مراحل وجودهم في الحياة.
إنّ أمر الاستبعاد والاستهوال لعلم الأئمّة بالغيب والشامل للماضي والحاضر والمستقبل، سوف يهون إذا عُرف أنّه ليس بالاستقلال، بل بواسطة الوحي الإلٰهي المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ومن خلال الإلهام لآله الأطهار.
وقد استفاضت الأحاديث والأخبار والآثار الدالّة على كثير من ذلك، حتّى عُدّت من «دلائل النبوّة» ومعاجز الرسالة، وقد جمعتها كتب بهذا العنوان، وتناقلتها الرواة، ومُلئت بها الصحف.
فإذا اتّفقت عليه عقول السامعين لتلك الأخبار، وشاهدتها عيون الشاهدين لتلك الأحداث، واستيقنتها قلوب المؤمنين بالغيب وبالرسالة المحمّدية؛ فماذا على ذلك من جحود عقلٍ خامدٍ؟!
وإذا بلغت الروايات الدالّة على «إنباء السماء بأنباء كربلاء» حدّ التواتر، وذاعت وانتشرت حتّى رواها الشيعة وأهل السنّة، وأثبتها المؤلّفون في كتب «دلائل النبوّة» كأبي نعيم والبيهقي، حتّى عدّ من أعظم معاجز النبوّة وأهمّ ما يصدّقها؛ فماذا عليها من عقلٍ واحدٍ أن يُنكرها! ولا يصدّق بها؟!
هذا ما نقوله في الجواب عن الاعتراض الأوّل، وحاصله ثبوت علم الغيب للنبيّ والإمام عليهم السلام من خلال الوحي والإلهام، وهو الّذي التزم به جمهور علماء الإماميّة، ولم نجد فيه مخالفاً قطّ، إلّاظاهر من التزم بإثبات العلم بالإجمال ببعض الأُمور دون التفصيل، وسيأتي نقل كلامه ومناقشته.
ومن هنا، فإنّ المحور الّذي سنتحدّث عنه إنّما هو حول الاعتراض الثاني،
ص: 49
وسنستعرض صيغه عبر القرون، ونذكر أشكال الإجابة عنه.
إنّ تفسيرنا لآيات الغيب الواردة في القرآن الكريم، لم تنفرد به الشيعة الإماميّة، بل التزم به كثيرٌ من علماء العامّة من أهل السنّة، مفسّرين، وفقهاء، وعلماء كلام، وغيرهم.
وقد ذكر العلّامة الحجّة المتتبّع السيّد عبد الرزّاق الموسوي المقرّم، مؤلّف مقتل الحسين عليه السلام(1) أقوالهم بهذا الصدد. وإليك ما نقله السيّد المقرّم بنصّه ومصادره:
ص: 50
قال ابن حجر الهيثمي [وهو المكّي صاحب الصواعق المحرقة]:
لا منافاة بين قوله تعالى: «قُلْ لاٰ يَعْلَمُ مَنْ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللّٰهُ »(1) ، وقوله: «عٰالِمُ اَلْغَيْبِ فَلاٰ يُظْهِرُ عَلىٰ غَيْبِهِ أَحَداً»(2) ، وبين علم الأنبياء والأولياء بجزئيّات من الغيب، فإنّ علمهم إنّما هو بإعلامٍ من اللّٰه تعالى، وهذا غير علمه الّذي تفرّد تعالى شأنه به من صفاته القديمة الأزليّة الدائمة الأبديّة المنزّهة عن التغيير.
وهذا العلم الذاتي هو الّذي تمدّح به، وأخبر - في الآيتين - بأنّه لا يشاركه أحدٌ فيه، وأمّا من سواه، فإنّما يعلم بجزئيّات الغيب بإعلامه تعالى. وإعلام اللّٰه للأنبياء والأولياء ببعض الغُيوب ممكنٌ ، لا يستلزم محالاً بوجهٍ ، فإنكار وقوعه عنادٌ.
ومن البيّن أنّه لا يؤدّي إلى مشاركتهم له تعالى فيما تفرّد به من العلم الّذي تمدّح به
ص: 51
واتّصف به من الأزل. وعلى هذا مشى النووي في فتاواه(1).
وقال النيسابوري صاحب التفسير:
إنّ امتناع الكرامة من الأولياء عليهم السلام، إمّا لأنّ اللّٰه ليس [معاذ اللّٰه] أهلاً لأن يعطي المؤمن ما يريد! وإمّا لأنّ المؤمن ليس أهلاً لذلك! وكلّ منهما بعيدٌ، فإنّ توفيق المؤمن لمعرفته لمن أشرف المواهب - منه تعالى - لعبده، فإذا لم يبخل الفيّاض بالأشرف، فلأن لا يبخل بالدون أولى(2).
وقال ابن أبي الحديد:
إنّا لا ننكر أن يكون في نوعٌ من البشر أشخاصٌ يخبرون عن الغيوب، وكلّه مستندٌ إلى الباري جلّ شأنه، بإقداره وتمكينه وتهيئة أسبابه»(3).
وقال ابن أبي الحديد - أيضاً:
لا مُنافاة بين قوله تعالى: «وَ مٰا تَدْرِي نَفْسٌ مٰا ذٰا تَكْسِبُ غَداً»(4) ، وبين علمه صلى الله عليه و آله و سلم بفتح مكّة، وما سيكون من قتال الناكثين والقاسطين والمارقين؛ فإنّ الآية - غاية ما تدلّ عليه - نفي العلم بما يكون في الغد، وأمّا إذا كان بإعلام اللّٰه عزّ وجلّ ، فلا، فإنّه يجوز أن يُعلم اللّٰه نبيّه بما يكون(5).
وفي عنوان «آية التهلكة» قال المقرّم: وقد أثنى سبحانه وتعالى على المؤمنين في إقدامهم على القتل والمجاهدة في سبيل تأييد الدعوة الإلهيّة. وذكر بعض آيات القتال في سبيل اللّٰه.
ولم يتباعد عن هذه التعاليم محمّد بن الحسن الشيباني، فينفي البأس عن رجل يحمل على الألف مع النجاة أو النكاية، ثمّ قال:
ص: 52
ولا بأس بمن يفقد النجاة أو النكاية إذا كان إقدامه على الألف ممّا يُرهب العدوّ ويُقلق الجيش»، معلّلاً بأنّ هذا الإقدام أفضل من النكاية؛ لأنّ فيه منفعةً للمسلمين(1).
ويقول ابن العربي المالكي:
جوّز بعض العلماء أن يحمل الرجل على الجيش العظيم طالباً للشهادة، ولا يكون هذا من الإلقاء بالتهلكة؛ لأنّ اللّٰه تعالى يقول: «مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اَللّٰهِ ...»(2) ، خصوصاً إذا أوجب الإقدام تأكّد عزم المسلمين حين يرون واحداً منهم قابل الأُلوف»(3).
فإذن، لم يمنع مانعٌ شرعيٌّ ولا عقليٌّ من إمكان علم البشر بالغيب في نظر هؤلاء، وهذا ما يقوله الشيعة الإماميّة في النبيّ والإمام عليهم السلام.
والدليل على «علم النبيّ والإمام» بالغيب من طريق الوحي والإلهام، هو ما أقاموه في الكتب الكلاميّة على وجوب مثل ذلك العلم لهما، لتصدّيهما لمقام الرسالة في الرسول، والإمامة في الإمام، وهذان المقامان يقتضيان العلم، فمن أقرّ للأئمّة بالإمامة، فلا موقع عنده للاعتراض بالإلقاء إلى التهلكة، كما أوضحنا في الأُمور الّتي قدّمناها. وكذلك من نفى عنهم علم الغيب، لعدم التزامه بالإمامة لهم، إذ على فرض ذلك لم يصدق في حقّهم «الإقدام» المحرّم.
وإثبات علمهم بالغيب، مع نفي إمامتهم، قولٌ ثالثٌ لم يقل به أحدٌ. نعم، يمكن فرض علمهم بالغيب باعتبارهم أولياء للّٰه، استحقّوا ذلك لمقاماتهم الروحيّة، وقرباتهم المعنويّة، وتضحياتهم في سبيل اللّٰه، وإخلاصهم في العبادة والولاية للّٰه - بقطع النظر عن مقام الإمامة - وحينئذٍ يتساءل: كيف أقدموا على الموت والقتل،
ص: 53
وهم يعلمون ؟! فإنّ الأجوبة التالية الّتي نقلناها وأثبتناها في بحثنا هذا تكون مقنعةً لمثل من يقدّم هذا السؤال، مع التزامه بهذا الفرض!
عُرضت المشكلة على الإمام أبي الحسن الرضا عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد عليه السلام (ت 203 ه) فيما رواه الكليني رحمه الله في الكافي كتاب الحجّة، باب «أنّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون، وأنّهم لا يموتون إلّاباختيارٍ منهم»، الحديث الرابع:
عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للرضا عليه السلام: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله، والليلة الّتي يُقتل فيها، والموضع الّذي يُقتل فيه، وقوله - لمّا سمع صياح الإوزّ في الدار -:
«صوائح تتبعها نوائح»! وقول أُمّ كلثوم: «لو صلّيت الليلة داخل الدار، وأمرت غيرك يُصلّي بالناس»، فأبىٰ عليها! وكثر دخولُه وخروجُه تلك الليلة بلا سلاحٍ ! وقد عرف عليه السلام أنّ ابن ملجمٍ لعنه اللّٰه قاتلُه بالسيف! كان هذا ممّا لم يجُز(1) تعرّضُه ؟!
فقال: ذلك كانَ ، ولكنّه خُيّرَ(2) في تلك الليلة، لتمضيَ مقادير اللّٰه عزّ وجلّ (3).
والمستفاد من هذا الحديث أُمور:
الأوّل: إنّ المشكلة كانت مطروحةً منذ عهود الأئمّة، وعلى المستوى الرفيع، إذ عرضها واحدٌ من كبار الرواة، وهو الحسن بن الجهم بن بُكير بن أعين، أبو محمّد الزُراري الشيباني، من خواصّ الإمام الرضا عليه السلام، وروى عن الإمام الكاظم عليه السلام وعن جمعٍ من أعيان الطائفة، وقد صرّح بتوثيقه، وله كتابٌ معروفٌ رواه أصحاب
ص: 54
الفهرستات، وله حديثٌ كثيرٌ في الكتب الأربعة(1)، وهو من كبار آل زُرارة، البيت الشيعيّ المعروف بالاختصاص بالمذهب.
الثاني: إنّ علم الإمام ومعرفته بوقت مقتله، وما ذكر في الرواية من الأقوال والأفعال الدالّة على اختياره للقتل وإقدامه على ذلك، كلّها أُمور كانت مسلّمة الوقوع، ومعروفة في عصر السائل.
الثالث: إنّ الراوي إنّما سأل عن وجه إقدام الإمام عليه السلام على هذه الأُمور، وإنّه مع العلم بترتّب قتله على ذلك، كيف يجوز له تعريض نفسه له ؟ وهو مضمون الاعتراض الثاني.
الرابع: إنّ جواب الإمام الرضا عليه السلام بقوله: «ذلك كان» تصديق بجميع ما ورد في السؤال من أخبار «علم الإمام»، والأقوال والأفعال الّتي ذكرها السائل وعدم معارضة الإمام الرضا عليه السلام لشيءٍ من ذلك وعدم إنكاره، كلّ ذلك دليل على موافقة الإمام الرضا عليه السلام على اعتقاد السائل بعلم الإمام بوقت قتله.
الخامس: جواب الإمام الرضا عليه السلام عن السؤال بتوجيه إقدام الإمام وعدم الاعتراض على أصل فرض علم الغيب، دليلٌ على قبول هذا الفرض، وعدم ثبوت الاعتراض الأوّل.
السادس: قول الإمام عليه السلام في الجواب: «لكنّه خُيِّرَ» صريحٌ في أنّ الإمام عليه السلام أُعطي الخيرة من أمر موته، فاختار القتل لتجري الأُمور على مقاديرها المعيّنة في الغيب، وليكون أدلّ على مطاوعته لإرادة اللّٰه وانقياده لتقديره، وهذا أوضح المعاني، وأنسبها بعنوان الباب.
وعلى نسخة «حُيّن» الّتي ذكرها المجلسي، فالمعنى أنّ القتل قد عيّن حينُه ووقتُه، لمقادير قدّر اللّٰه أن تُمضي وتتحقّق، فتكون دلالة الحديث على ما في العنوان من
ص: 55
مجرّد ثبوت علم الإمام بوقت قتله وإقدامه، وعدم امتناعه وعدم دفعه عن نفسه، وذلك يتضمّن أنّ الإمام وافق التقدير وجرى على وفقه.
وأمّا نسخة «حُيّر» فلا معنى لها؛ لأنّ تحيّر الإمام ليس له دخل في توجيه إقدامه على القتل عالماً به، بل ذلك مناقض لهذا الفرض، مع أنّه لا يناسب عنوان الباب، فيكون احتمالها مرفوضاً. ولعلّها مصحّفة عن «خُبِّرَ» بمعنى أُعلم، فيكون الجريان على التقدير وإمضائه تعليلاً لإخبار الإمام وإعلامه، لكنّه لا يخلو من تأمّل.
فالأولى بالمعنى والأنسب بالعنوان هو «خُيّر» كما أوضحنا، فدلالة الحديث على ثبوت علم الإمام بوقت موته واختياره في ذلك، واضحة جدّاً.
وحاصل الجواب عن الاعتراض بالإلقاء في التهلكة: هو أنّ الإمام إنّما اختار الموت والقتل بالكيفيّة الّتي جرى عليها التقدير الإلهيّ ، حتّى يكشف عن منتهى طاعته للّٰه وانقياده لإرادته وحبّه له وفنائه فيه وعشقه له ورغبته في لقائه، كما نُقل عنهم قولهم عليهم السلام: «رضاً لرضاك، تسليماً لأمرك، لا معبود سواك».
هو المحدّث الأقدم أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي، مجدّد القرن الرابع، المتوفّى سنة 329 ه، وقد عاش في عصر الغيبة الصغرى، وعاصر من الوكلاء ثلاثة، وقد احتلّ بين الطائفة مكانةً مرموقةً ، وله بين علماء الإسلام منزلةٌ عظيمةٌ ، ننقل بعض ما قاله الكبراء في حقّه:
قال النجاشيّ (ت 450 ه):
شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم.
وقال الطوسيّ (ت 460 ه):
ثقة عارف بالأخبار، جليل القدر.
وقال العامّة فيه:
ص: 56
من فقهاء الشيعة، ومن أئمّة الإماميّة وعلمائهم.
وقال السيّد بحر العلوم (ت 1212 ه):
ثقة الإسلام، وشيخ مشايخ الأعلام، ومروّج المذهب في غيبة الإمام عليه السلام ذكره أصحابنا... واتّفقوا على فضله وعظم منزلته(1).
وكتابه العظيم الكافي أوّل الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة في الحديث وأجلّها وأوسعها، والّذي مجّد به كبار الطائفة وأعلامهم:
فقال المفيد (ت 413 ه) فيه:
هو من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة.
وقال الشهيد الأوّل (ت 786 ه):
كتاب الكافي في الحديث الّذي لم يعمل الإماميّة مثله.
وقال المازندراني (ت 1081 ه) وهو شارح الكافي:
كتاب الكافي أجمع الكتب المصنّفة في فنون علوم الإسلام، وأحسنها ضبطاً، وأضبطها لفظاً، وأتقنها معنىً ، وأكثرها فائدةً ، وأعظمها عائدةً ، حائز ميراث أهل البيت، وقمطر علومهم.
وقال السيّد بحر العلوم (ت 1212 ه):
إنّه كتاب جليل، عظيم النفع، عديم النظير، فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب، وزيادة الضبط والتهذيب، وجمعه للأُصول والفروع، واشتماله على أكثر الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام(2).
لقد عقد الشيخ الكليني في كتابه الكافي باباً في كتاب «الحجّة» بعنوان: «باب أنّ
ص: 57
الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون ؟ وأنّهم لا يموتون إلّاباختيار منهم»، وأورد فيه ثمانية أحاديث تدلّ على ما في العنوان، ومنها الحديث المذكور سابقاً، عن الإمام الرضا عليه السلام.
وعقدُ الكلينيّ لهذا الباب بهذا العنوان يدلّ بوضوحٍ على أنّ المشكلة كانت معروضةً في عصره، وبحاجةٍ إلى حسُمٍ ، فلذلك لجأ إلى عقده.
فلنمرّ بمضمون الأحاديث، كي نقف على مداليلها(1):
الحديث الأوّل: بسنده عن أبي بصير، قال:
قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: أيّ إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير، فليس ذلك بحجّة للّٰه على خلقه.
ودلالته على عنوان الباب واضحة.
الحديث الثاني: بسنده عمّن دخل على موسى الكاظم عليه السلام فأخبره:
أنّه قد سُقي السمّ ، وغداً يحتضر، وبعد غدٍ يموت.
ودلالته على علم الإمام بوقت موته واضحة.
الحديث الثالث: بسنده عن جعفر الصادق عليه السلام، عن أبيه الباقر عليه السلام:
إنّه أتى أباه عليّ بن الحسين السجّاد عليه السلام، قال له: إنّ هذه الليلة الّتي يُقبض فيها، وهي الليلة الّتي قُبض فيها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم.
ودلالته على علم الإمام بليلة وفاته واضحة.
الحديث الرابع: وقد أوردناه في المقطع السابق بعنوان «عصر الإمام الرضا عليه السلام».
الحديث الخامس: بسنده عن الإمام أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام وفيه:
إنّ اللّٰه غضب على الشيعة، وأنّه خيّره نفسه أو الشيعة، وأنّه وقاهم بنفسه.
ودلالته على تخييره بين أن يصيبهم بالموت، أو يصيبه هو، وعلى اختياره الموت وقاءً لهم، واضحةٌ .
ص: 58
الحديث السادس: بسنده إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه قال لمسافر الراوي:
إنّه رأى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وهو يقول له: يا عليّ ، ما عندنا خيرٌ لك.
ومن الواضح أنّ هذا القول هو دعوةٌ للإمام إلى ما عند رسول اللّٰه، وهو كناية واضحة عن الموت، وقد مثّل الإمام الرضا عليه السلام وضوح ذلك بوضوح وجود الحيتان في القناة الّتي أشار إليها في صدر الحديث.
الحديث السابع: بسنده عن أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام:
إنّ أباه أوصاه بأشياءٍ في غسله وفي كفنه وفي دخوله قبره، وليس عليه أثر الموت، فقال الباقر عليه السلام: يابنيّ ، أما سمعت عليّ بن الحسين عليه السلام يُنادي من وراء الجدار:
يامحمّد، تعال، عجّل.
ودلالته مثل دلالة الحديث السابق، في كون الدعوة إلى الدار الأُخرى، والقرينة هنا أوضح، حين أوصى الإمام بتجهيزه.
ودلالة هذين الحديثين على ثبوت الاختيار للإمام واضحة، إذ إنّ مجرّد الدعوة ليس فيها إجبارٌ على الامتثال، بل يتوقّف على الإجابة الاختياريّة لذلك.
الحديث الثامن: بسنده عن عبد الملك بن أ عين، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أنزل اللّٰهُ تعالى النصرَ على الحسين عليه السلام حتّى كان بينَ السماء والأرض، ثمّ خُيّر النصرَ أو لقاءَ اللّٰه، فاختار لقاءَ اللّٰه تعالى.
ودلالته على ما في عنوان الباب واضحةٌ ، للتصريح فيه بالتخيير ثمّ اختيار الإمام لقاء اللّٰه.
ومع وضوح دلالة جميع هذه الأحاديث على ما في عنوان الباب كما شرحناه، فلا يرد نقدٌ إلى الكليني، ولا الكافي، ولا هذا الباب بالخصوص، ومن حاول التهجّم على كتاب الكافي والتشكيك في صحّة نسخه والمناقشة في أسانيد هذه الأحاديث، فهو بعيدٌ عن العلم وأساليب عمل العلماء. والتشكيك في دلالة الأحاديث على مدلول عنوان الباب، يدلّ على الجهل باللغة العربيّة ودلالتها اللفظيّة، والبعد عن أوّليّات
ص: 59
علم الكلام بشكلٍ مكشوف ومفضوح.
فلا نجد من اللّازم التعرّض لكلّ ما ذكر في هذا المجال، إلّاأنّ محاولة التهجّم على الكتاب وأسانيده لا بدّ من ذكرها وتفنيدها، وهي:
أوّلاً: ما ذكر تبعاً لمستشرق أمريكي أثار هذه الشبهة، من أنّ نُسخ كتاب الكافي مختلفة، وأنّ هناك فرقاً بين رواية الصفواني ورواية النعماني للكتاب، وبين النسخة المطبوعة المتداولة.
نقول: إنّ تلاميذ الكليني الّذين رووا عنه كتاب الكافي بالخصوص كثيرون، وقد صرّح علماء الرجال بروايتهم للكتاب عن مؤلّفه الكليني، وهم: الصفواني، والنعماني، وأبو غالب الزراري، وأبو الحسن الشافعي، وأبو الحسين الكاتب الكوفي، والصيمري، والتلّعُكبري، وغيرهم(1).
وإن دلّت كثرة الرواة على شيء فإنّما تدلّ على أهمّية الكتاب والعناية به والتأكّد من نصّه، ولا بدّ أن يبذل المؤلّف والرواة غاية جهدهم في تحقيق عمليّة المحافظة عليه، والتأكّد من بلوغه بالطرق الموثوقة المتعارفة لتحمّل الحديث وأدائه.
أمّا الاختلاف بين النسخ على أثر وقوع التصحيف والسهو في الكتابة، وعلى طول المدّة الزمنيّة بيننا وبين القرن الرابع على مدى عشرة قرون، فهذا أمرٌ قد مُني به تُراثنا العربيّ ، فهل يعني ذلك التشكيك في هذا التراث كلّه ؟! كلّا، فإنّ علماء الحديث قد بذلوا جهوداً مضنيّةً في الحفاظ على هذا التراث وجمع نسخه والمقارنة بينها، والترجيح والاختيار والتحقيق والتأكّد من النصّ ، شأنهم في ذلك شأن العلماء في عملهم مع النصوص الأُخرى، من دون أن يكون لمثل هذه التشكيكات أثرٌ في حجّيتها أو سلب إمكان الإفادة منها، ما دامت قواعد التحقيق والتأكّد والتثبّت، متوفّرةً ، والحمد للّٰه.
ص: 60
أمّا تهريج الجهلة بأساليب التحقيق، وبقواعد البحث العلمي في انتخاب النصوص، وإثارتهم وجود نسخ مختلفة، فهو نتيجةٌ واضحةٌ للأغراض المنبعثة من الحقد والكراهيّة للعلم، وقديماً قيل: «الناس أعداء ما جهلوا».
وثانياً: مناقشة الأحاديث المذكورة، من حيث أسانيدها، ووجود رجال موسومين بالضعف فيها.
والردّ على ذلك: إنّ البحث الرجالي، ونقد الأسانيد بذلك، لا بدّ أن يعتمد على منهجٍ رجاليٍّ محدّدٍ، يتّخذه الناقد، ويستدلّ عليه، ويطبّقه، وليس ذلك حاصلاً بمجرّد تصفّح كتب الرجال، ووجدان اسم لرجل، والحكم عليه بالضعف أو الثقة، تبعاً للمؤلّفين الرجاليّين وتقليداً لهم، مع عدم معرفة مناهجهم وأساليب عملهم.
وإنّ من المؤسف ما أصاب هذا علم رجال الحديث، إذ أصبح ملهاةً للصغار من الطلبة يناقشون به أسانيد الأحاديث، مع جهلهم بالمناهج الرجاليّة الّتي أسّس مؤلّفوا علم الرجال كتبهم عليها، وبنوا أحكامهم الرجالية على أساسها، مع أهمّية ما يبتني على تلك الأحكام من إثبات ونفي، وردٍّ وأخذٍ لأحاديث وروايات في الفقه والعقائد والتاريخ، وغير ذلك.
كما إنّ معرفة الحديث الشريف، وأساليب تأليفه ومناهج مؤلّفيه له أثرٌ مهمّ في مداولة كتبهم والاستفادة منها، ولقد أساء من أقحم - ولا يزال يقحم الطلبة في وادي هذا العلم الصعب المسالك، فيصرفون أوقاتهم الغالية في مناقشات ومحاولات عقيمة، ويبنون عليها الأحكام والنتائج الخطيرة.
كالمناقشة في أسانيد أحاديث هذا الباب الّذي نبحث عنه في كتاب الكافي للشيخ الكليني، فقد جهل المناقش أُموراً من مناهج النقد الرجالي، ومن أُسلوب عمل الكليني، فخبط - خبط عشواء - في توجيه النقد إلى الكافي.
فمن ناحية: إنّ قسم الأُصول من الكافي إنّما يحتوي على أحاديث ترتبط بقضايا عقائدية، وأُخرى موضوعات لا ترتبط بالتعبّد الشرعيّ ، كالتواريخ وأحوال الأئمّة
ص: 61
ومجريات حياتهم.
ومن المعلوم أنّ اعتبار السند، وحاجته إلى النقد الرجالي بتوثيق الرواة أو جرحهم، إنّما هو لازمٌ في مقام إثبات الحكم الشرعيّ للتعبّد به؛ لأنّ طريق اعتبار الحديث توصّلاً إلى التعبّد به متوقّف على اعتباره سنديّاً، بينما القضايا الاعتقادية، والموضوعات الخارجيّة لا يمكن التعبّد بها؛ لأنّها ليست من الأحكام الشرعية، فليس المراد منها هو التعبّد بمدلولها والتبعيّة للإمام فيها، وإنّما المطلوب الأساسي منها هو القناعة والالتزام القلبي واليقين، وليس شيء من ذلك يحصل بالخبر الواحد حتّى لو صحّ سنده وقيل بحجّيته واعتباره؛ لأنّه على هذا التقدير لا يفيد العلم، وإنّما يعتبر للعمل فقط.
نعم، إنّ حاجة العلماء إلى نقل ما روي من الأحاديث في أبواب الأُصول الاعتقادية، لمجرّد الاسترشاد بها، والوقوف من خلالها على أساليب الاستدلال والطرق القويمة المحكمة الّتي يتّبعها أئمّة أهل البيت عليهم السلام في الإقناع والتدليل على تلك الأُصول، ولا يفرّق في مثل هذا أن يكون الحديث المحتوي عليه صحيح السند أو ضعيفه، ما دام المحتوى وافياً بهذا الغرض وموصلاً إلى الإقناع الفكري بالمضمون.
وليس التشكيك في سند الحديث المحتوي على الإقناع مؤثّراً لرفع القناعة بما احتواه من الدليل، وكذا الموضوعات الخارجيّة، كالتواريخ، وسنيّ الأعمار، وأخبار السيرة، ليس فيها شيءٌ يتعبّد به حتّى تأتي فيه المناقشة السنديّة، وإنّما هي أُمور ممكنة، يكفي - في الالتزام بها ونفي احتمال غيرها - ورود الخبر به.
فلو لم يمنع - من الالتزام بمحتوى الخبر الوارد - أصلٌ محكمٌ ، أو فرعٌ ملتزمٌ ، ولم تترتّب على الالتزام به مخالفة واضحة، أو لم تقم على خلافه أدلّةٌ معارضةٌ ، كفى الخبر الواحد في احتماله لكونه ممكناً، وإذا غلب على الظنّ وقوعه باعتبار كثرة ورود الأخبار به أو توافرها، أو صدور مثل ذلك الخبر من أهله الخاصّين بعلمه، أو ما يماثل
ص: 62
ذلك من القرائن والمناسبات المقارنة، كفى ذلك مقنعاً للالتزام به.
وبما أنّ موضوع قسم الأُصول من الكافي، وخاصّةً الباب الّذي أورد فيه الأحاديث المذكورة الدالّة على «علم الأئمّة عليهم السلام بوقت موتهم وأنّ لهم الاختيار في ذلك»، هو موضوع خارج عن مجال الأحكام والتعبّد بها، وليس الالتزام به منافياً لأصلٍ من الأُصول الثابتة، ولا لفرعٍ من الفروع الشرعيّة، ولا معارضاً لآية قرآنيّة، ولا لحديثٍ ثابتٍ في السنّة، ولا ينفيه دليلٌ عقليٌّ ، وقد وردت به هذه المجموعة من الأحاديث والآثار - مهما كان طريقها - فقد أصبح من الممكن والمحتمل والمعقول.
وإذا توافرت الأحاديث وتكرّرت، كما هو في أحاديث الباب، ودلّت القرائن الأُخرى المذكورة في كتب السيرة والتاريخ، وأيّدت الأحاديث المنبئة عن تلك المضامين، حصل من مجموع ذلك وثوقٌ واطمئنان بثبوته. ولا ينظر في مثل ذلك إلى مفردات الأسانيد ومناقشتها رجاليّاً.
ومن ناحيةٍ أُخرى: فإنّ المنهج السائد في عرف قدماء العلماء وأعلام الطائفة، هو اللجوء إلى المناقشة الرجاليّة في الأسانيد، ومعالجة اختلاف الحديث بذلك، في خصوص موارد التعارض والاختلاف.
وقد يستدلّ على هذه السيرة وقيام العمل بها، باعتمادهم في الفقه وغيره على الأحاديث المرسلة المقبولة والمتداولة وإن كانت لا سند لها، فضلاً عن المقطوعة الأسانيد، في صورة انفرادها بالحكم في الموقف. وللبحث عن هذا المنهج، وقبوله أو مناقشته، مجال آخر.
هذا، مع أنّ الكليني لم يكن غافلاً - قطّ - عن وجود هذه الأسماء في أسانيد الأحاديث، لتسجيله لها وعقد باب لها في كتابه، كيف، وهو من روّاد علم الرجال، وقد ألّف كتاباً في هذا العلم باسم «الرجال»(1)؟!
ص: 63
أمّا اتّهام الرواة لهذه الأحاديث بالارتفاع والغلوّ، ومحاسبة المؤلّف الكليني على إيرادها لأنّها تحتوي على ثبوت علم الغيب للأئمّة عليهم السلام، فهذا مبنيٌ على الجهل بأبسط المصطلحات المتداولة بين العلماء، فالغلوّ اسمٌ يطلق على نسبة الربوبيّة إلى البشر - والعياذ باللّٰه -، بينما هذا الباب معنونٌ ب «أنّ الأئمّة يعلمون متى يموتون...»، فعنوان الباب يتحدّث عن «موت الأئمّة»، وهذا يناقض القول ب «الغلوّ» وينفيه.
فجميع رواة هذا الباب، يبتعدون - بروايتهم له - عن الغلوّ المصطلح، قطعاً، فكيف يتّهمهم بالغلوّ؟!
هذا، والكلينيُّ نفسه ممّن ألّف كتاباً في الردّ على «القرامطة»، وهم فرقة تُنسب إلى الغلاة(1) ممّا يدلّ على استيعاب الكليني وتخصّصه في أمر الفرق، فكيف يحاسب بمثل ذلك ؟!
ثمّ إنّ قول الكليني في عنوان الباب: «وإنّهم لا يموتون إلّاباختيارٍ منهم»، يعني أنّ الموت الإلٰهي الّذي قهر اللّٰه به عباده وما سواه، بدون استثناء، وتفرّد هو بالبقاء دونهم، لا بدّ أن يشمل الأئمّة - لا محالة - ولا مفرّ لهم منه، وإنّما امتازوا بين سائر الخلائق بأن جعل اللّٰه اختيارهم لموتهم إليهم، وهذا يوحي:
أوّلاً: إنّ لهم اختيار وقت الموت، فيختارون الآجال المعلّقة قبل أن تُحتم، فيكون ذلك بإرادة منهم واختيار وعلم، رغبةً منهم في سرعة لقاء اللّٰه، وتحقيقاً للآثار العظيمة المترتّبة على شهادتهم في ذلك الوقت المختار. وهذا أنسب بكون
ص: 64
إقداماتهم مع كامل اختيارهم، وعدم كونها مفروضة عليهم، وأنسب بكون ذلك مطابقاً لقضاء اللّٰه وقدره، فهو يعني إرادة اللّٰه منهم لما أقدموا عليه، من دون حتم، وإلّا، فإن كان قضاءً مبرماً وأجلاً حتماً لازماً، فكيف يكونون مختارين فيه ؟! وما معنى موافقتهم على ما ليس لهم الخروج عنه إلى غيره ؟!
ثانياً: إنّ لهم اختيار نوع الموت الّذي يموتون به، من القتل بالسيف ضربةً واحدةً ، كما اختار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ذلك، أو بشرب السُمّ أو أكل المسموم كما اختاره أكثر الأئمّة عليهم السلام، أو بتقطيع الأوصال وفري الأوداج واحتمال النصال والسهام وآلام الحرب والنضال، وتحمّل العطش والظمأ، كما جرى على الإمام سيّد الشهداء عليه السلام.
ولايأبى عموم لفظ العنوان «لا يموتون إلّاباختيارٍ منهم» عن الحمل على ذلك كلّه.
مع أنّ في المعنى الثاني بُعداً اجتماعياً هامّاً، وهو: إنّ الأئمّة الأطهار عليهم السلام كانوا يعلمون من خلال الظروف، والأحداث، والمؤشّرات والمجريات، المحيطة بهم - بلا حاجة إلى الاعتماد على الغيب وإخباره - أنّ الخلفاء الظلمة، والمتغلّبين الجهلة على حكم العباد والبلاد، سيقدمون على إزهاق أرواحهم المقدّسة بكلّ وسيلة تمكّنهم؛ لأنّهم لا يطيقون تحمّل وجود الأئمّة عليهم السلام الرافضين للحكومات الجائرة والفاسدة، والّتي تحكم وتتحكّم على الرقاب بالباطل وباسم الإسلام، ليشوّهوا سمعته الناصعة بتصرّفاتهم الشوهاء.
فكان الأئمّة الأطهار تجسيداً للمعارضة الحقّة الحيّة، ولو كانوا في حالة من السكوت، وعدم مدّ اليد إلى الأسلحة الحديديّة، لكنّ وجوداتهم الشريفة كانت قنابل قابلة للانفجار في أيّ وقت! وتعاليمهم كانت تمثّل الصرخات المدوّية على أهل الباطل، ودروسهم وسيرتهم كانت تمثّل الشرارات ضدّ تلك الحكومات! فكيف تطيق الأنظمة الفاسدة وجود هؤلاء الأئمّة، لحظة واحدة ؟!
فإذا كان الأئمّة عليهم السلام يعلمون أنّ مصيرهم - مع هؤلاء - هو الموت، ويعرفون أنّ الظلمة يكيدون لهم المكائد، ويتربّصون بهم الدوائر، ويدبّرون لقتلهم والتخلّص من
ص: 65
وجودهم، ويسعون في أن ينفّذوا جرائمهم في السرّ والخفاء، لئلّا يتحمّلوا مسؤولية ذلك، ولا يحاسبوا عليه أمام الناس والتاريخ! فلو تمّ لهم إبادة هؤلاء الأئمّة سرّاً وبالطريقة الّتي يرغبون فيها، لكان أنفع لهم، وأنجع لأغراضهم! لكنّ الأئمّة عليهم السلام لا بدّ أن يُحبطوا هذه المكيدة على الظلمة القتلة.
فعند ذلك عليهم أن يأخذوا بأيديهم زمام المبادرة في هذا المجال المهمّ الخطر، ويختاروا بأنفسهم أفضل أشكال الموت الّذي يُعلن مظلوميتهم، ويصرخ بظُلاماتهم، ويفضح قاتليهم، ويُعلن عن الإجرام والكيد الّذي جرى عليهم، ولا تضيع هدراً نفوسهم البريئة، ولا دماؤهم الطاهرة.
فلو كان الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام يُقتل في بيته أو في بعض الأزقّة والطرق خارج المسجد، فمن كان يفنّد الدعايات الكاذبة الّتي بثّها بنو أُميّة بين أهل الشام بأنّ عليّاً عليه السلام لا يصلّي ؟! فلمّا سمعوا أنّه قُتل في المسجد، تنبّهوا إلى زيف تلك الدعايات المضلّلة.
وإذا كان الإمام الحسين عليه السلام يُقتل في المدينة، فمن كان يطّلع على قضيّته ؟! وحتّى إذا كان يُقتل في «مكّة»، فمضافاً إلى أنّه كان يُعاب عليه أنّ حرمة الحرم قد هُتكت بقتله! فقد كان يضيع دمه بين صخب الحجيج وضجيجهم! بل إذا قُتل الحسين عليه السلام في أرض غير كربلاء، فأين ؟! وكيف ؟! وما هو تفسير كلّ النصوص الّتي تناقلتها الصحف، والأخبار عن جدّه النبيّ المختار صلى الله عليه و آله و سلم حول الفرات وكربلاء وتربتها الحمراء؟!
وهذا الاختيار يدلّ - مضافاً إلى كلّ المعاني العرفانيّة الّتي نستعرضها - على تدبيرٍ حكيمٍ ، وحنكةٍ سياسيّةٍ ، ورؤيةٍ نافذةٍ ، وحزمٍ محكمٍ ، قام به الأئمّة عليهم السلام في حياتهم السياسيّة تجاه الظالمين المستحوذين على جميع المقدّرات، والّذين سلبوا من الأُمّة كلّ الحرّيات حتّى حريّة انتخاب الموت كمّاً وكيفاً ووقتاً ومكاناً.
فإنّ خروج الأئمّة عليهم السلام بتدابيرهم الحكيمة عن سلطة الحكّام في هذه المعركة،
ص: 66
وتجاوزهم لإرادتهم وأخذ زمام الاختيار بأيديهم، وانتخابهم للطريقة المثلى لموتهم، يُعدّ انتصاراً باهراً في تلك الظروف الحرجة القاهرة.
ولقد قلت - عن مثل هذا - في كتابي الحسين عليه السلام سماته وسيرته ما نصّه:
وهل المحافظة على النفس، والرغبة في عدم إراقة الدماء، والخوف من القتل، أُمور تمنع من أداء الواجب، أو تعرقل مسيرة المسؤوليّة الكبرى، وهي: المحافظة على الإسلام وحرماته، وإتمام الحجّة على الأُمّة بعد دعواتها المتتالية، واستنجادها المتتابع ؟!
ثمّ هل تُعقل المحافظة على النفس، بعد قطع تلك المراحل النضالية، والّتي كان أقلّ نتائجها المنظورة القتل ؟! إذ أنّ يزيد صمّم وعزم على الفتك بالإمام عليه السلام الّذي كان يجده السدّ الوحيد أمام استثمار جهود أبيه في سبيل المُلك الأُموي العضوض، فلا بدّ من أن يزيحه عن الطريق.
ويتمنّى الحكم الأُموي لو أنّ الحسين عليه السلام كان يقف هادئاً ساكناً - ولو للحظة واحدة - حتّى يركّز في استهدافه وقتله!! وحبّذا لو كان قتل الحسين عليه السلام بصورة اغتيال، حتّى يضيع دمه وتهدر قضيّته!!
وقد أعلن الحسين عليه السلام عن رغبتهم في أن يقتلوه هكذا، وأنّهم مصمّمون على ذلك حتّى لو وجدوه في جُحر هامةٍ ! وأشار يزيد إلى جلاوزته أن يحاولوا قتل الحسين أينما وجدوه، ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة!
فلماذا لا يبادرهم الإمام عليه السلام إلى انتخاب أفضل زمان، وفي أفضل مكان، وبأفضل شكلٌ للقتل ؟! الزمان عاشوراء المسجّل في عالم الغيب والمثبّت في الصحف الأُولى وما تلاها من أنباء الغيب الّتي سنستعرضها، والمكان كربلاء الأرض الّتي ذُكر اسمها على الألسن منذ عصور الأنبياء.
أمّا الشكل الّذي اختاره للقتل، فهو النضال المستميت، الّذي ظلّ صداه، وصدى بطولاته، وقعقعات سيوفه، وصرخات الحسين عليه السلام المعلنة عن أهدافه ومظلوميّته، مدوّيةً في أُذن التاريخ على طول مداه، يقضّ مضاجع الظالمين، والمزوّرين للحقائق.
ص: 67
إنّ الإمام الحسين عليه السلام وبمثل ما قام به من الإقدام، أثبت خلود ذكره وحديث مقتله على صفحات الدهر، حتّى لا تناله خيانات المحرّفين، ولا جحود المنكرين، ولا تزييف المزوّرين، بل يخلد خلود الحقّ والدين(1).
وأخيراً: فإنّ الشيخ الكلينيّ وهو: «أوثق الناس في الحديث وأثبتهم» كما شهد له النجاشي، قد بنىٰ تأليف كتابه على أساسٍ محكمٍ ، ومن شواهد الإحكام فيه: أنّه رحمه الله عقد باباً بعنوان «باب نادر في ذكر الغيب» أورد فيه أحاديث تحلّ مشكلة الاعتراض الأوّل على «العلم بالغيب»، وفيه الجواب الصريح لقول السائل للأئمّة: «أتعلمون الغيب ؟» ويجعل نتيجة هذا الباب أصلاً موضوعاً للأبواب التالية.
ومن تلك الأحاديث: حديث حُمران بن أ عين، قال لأبي جعفر عليه السلام: «أرأيت قوله جلّ ذكره: «عٰالِمُ اَلْغَيْبِ فَلاٰ يُظْهِرُ عَلىٰ غَيْبِهِ أَحَداً» ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: «إِلاّٰ مَنِ اِرْتَضىٰ مِنْ رَسُولٍ ...»(2) ، وكان - واللّٰه - محمّد ممّن ارتضاه(3).
فقد كان الكليني يراعي ترتيب أبواب كتابه ترتيباً منهجيّاً برهانيّاً، حتّى تؤتي نتائجها الحتميّة بشكلٍ منطقيّ مقبول، فجعل من كتابه الكافي للدين سدّاً لا يستطيع الملحدون أن يظهروه بشبههم وتشكيكاتهم، ولا يستطيعون له نقباً.
الشيخ الإمام أبو عبد اللّٰه، محمّد بن محمّد بن النعمان، البغدادي، العكبري، الشهير بالشيخ المفيد، وابن المعلّم، مجدّد القرن الخامس (336-413 ه).
قال فيه النجاشي (ت 450 ه):
فضله أشهر من أن يُوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم(4).
ص: 68
وقال الطوسيّ (ت 460 ه):
جليل، ثقة، من جملة متكلّمي الإماميّة، انتهت إليه رئاسة الإماميّة في وقته، وكان مقدّماً في العلم، وصناعة الكلام، وكان فقيهاً متقدّماً فيه، حسن الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب(1).
قال ابن أبي طيّ (ت 630 ه):
كان أوحد في جميع فنون العلم: الأصلين، والفقه، والأخبار، ومعرفة الرجال، والتفسير، والنحو، والشعر، وكان يناظر أهل كلّ عقيدة، مع العظمة في الدولة البويهيّة، والرتبة الجسيمة عند الخلفاء، وكان قويّ النفس، كثير البرّ، عظيم الخشوع، كثير الصلاة والصوم، يلبس الخشن من الثياب، وكان مديماً للمطالعة والتعليم، ومن أحفظ الناس، قيل: إنّه ما ترك المخالفين كتاباً إلّاوحفظه. وبهذا قدر على حلّ شُبه القوم، وكان من أحرص الناس على التعليم، يدور على المكاتب وحوانيت الحاكة، فيتلمّح الصبيّ الفطن، فيستأجره من أبويه، وبذلك كثر تلاميذه(2).
وقال السيّد بحر العلوم (ت 1212 ه):
المفيد رحمه الله شيخ المشايخ الجلّة، ورئيس رؤساء الملّة، فاتح أبواب التحقيق بنصب الأدلّة، والكاسر بشقاشق بيانه الرشيق حجج الفرق المضلّة، اجتمعت فيه خلال الفضل، وانتهت إليه رئاسة الكلّ ، واتّفق الجميع على علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجلالته، وكان رضى الله عنه كثير المحاسن، جمّ المناقب، حديد الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب، واسع الرواية، خبيراً بالرجال والأخبار والأشعار، وكان أوثق أهل زمانه في الحديث، وأعرفهم بالفقه والكلام، وكلّ من تأخّر عنه استفاد منه(3).
لقد وجّه هذا الاعتراض إلى الشيخ المفيد ضمن المسائل الحاجبية، فأجاب عنه
ص: 69
ضمن الجوابات العكبرية المطبوعة، وإليك نصّ السؤال ثمّ الجواب:
المسألة العشرون: قال السائل: الإمام عندنا مجمع على أنّه يعلم ما يكون، فما بال أمير المؤمنين عليه السلام خرج إلى المسجد وهو يعلم أنّه مقتولٌ ، وقد عرف قاتله والوقت والزمان ؟!
وما بال الحسين عليه السلام صار إلى أهل الكوفة وقد علم أنّهم يخذلونه ولا ينصرونه، وأنّه مقتول في سفرته تلك ؟!
ولم - لمّا حُوصر، وقد علم أنّ الماء منه - لو حفر - على أذرع لم يحفر؟! ولم أعان على نفسه حتّى تلف عطشاً؟!
والحسن عليه السلام وادع معاوية، وهو يعلم أنّه ينكث ولايفي، ويقتل شيعة أبيه عليه السلام ؟!
عن قوله: «إنّ الإمام يعلم ما يكون بإجماعنا»! أنّ الأمر على خلاف ما قال، وما أجمعت الشيعة - قطّ - على هذا القول، وإنّما إجماعهم ثابتٌ على أنّ الإمام يعلم الحكم في كلّ ما يكون، دون أن يكون عالماً بأعيان ما يحدث ويكون، على التفصيل والتمييز. وهذا يُسقط الأصل الّذي بنى عليه الأسئلة بأجمعها.
فصل (1): لسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان حوادثٍ تكون بإعلام اللّٰه تعالى له ذلك.
فأمّا القول بأنّه يعلم كلّ ما يكون، فلسنا نُطلقُه، ولا نصوّب قائله، لدعواه فيه من غير حجّةٍ ولا بيانٍ .
فصل (2): والقول بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم قاتله، والوقت الّذي يقتل فيه، وقد جاء الخبر متضافراً: إنّه كان يعلم في الجملة أنّه مقتولٌ ، وجاء أيضاً بأنّه كان يعلم قاتله على التفصيل.
فأمّا علمه بوقت قتله، فلم يأت فيه أثر على التفصيل، ولو جاء فيه أثرٌ لم يلزم ما ظنّه المستضعفون، إذ كان لا يمتنع أن يتعبّده اللّٰه بالصبر على الشهادة والاستسلام
ص: 70
للقتل، ليبلغه اللّٰه بذلك علوّ الدرجة ما لا يبلغه إلّابه، ولعلمه تعالى بأنّه يُطيعه - في ذلك - طاعةً لو كلّفها سواه لم يؤدّها، ويكون - في المعلوم من اللطف بهذا التكليف لخلق من الناس - ما لا يقوم مقامه غيره.
فلا يكون أمير المؤمنين عليه السلام مُلقياً بيده إلى التهلكة، ولا مُعيناً على نفسه معونةً مستقبحةً في العقول.
فصل (3): فأمّا علم الحسين عليه السلام بأنّ أهل الكوفة خاذلوه، فلسنا نقطع على ذلك، إذ لا حجّة عليه من عقلٍ ولا سمعٍ ، ولو كان عالماً بذلك، لكان الجواب عنه ما قدّمناه في الجواب عن علم أمير المؤمنين عليه السلام بوقت قتله، والمعرفة بقاتله، كما ذكرناه.
فصل (4): أمّا دعواه علينا: إنّا نقول: إنّ الحسين عليه السلام كان عالماً بموضع الماء، وقادراً عليه، فلسنا نقول ذلك، ولا جاء به خبرٌ على حالٍ ، وظاهر الحال الّتي كان عليها الحسين عليه السلام في طلب الماء والاجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك.
ولو ثبت أنّه كان عالماً بموضع الماء، لم يمتنع في العقول أن يكون متعبّداً بترك السعي في طلب الماء من ذلك الموضع، ومتعبّداً بالتماسه من حيث كان ممنوعاً عنه، حسب ما ذكرناه في أمير المؤمنين عليه السلام، غير أنّ الظاهر خلاف ذلك، على ما قدّمناه.
فصل (5): والكلام في علم الحسن عليه السلام بعاقبة حال موادعته معاوية، بخلاف ما تقدّم، وقد جاء الخبر بعلمه ذلك، وكان شاهد الحال يقضي به، غير أنّه دفع به عن تعجيل قتله، وتسليم أصحابه إلى معاوية، وكان في ذلك لطفٌ في مقامه إلى حالٍ معيّنةٍ ، ولطفٌ لبقاء كثيرٍ من شيعته وأهله وولده، ورفعٌ لفسادٍ في الدين هو أعظم من الفساد الّذي حصل عند هُدنته.
وكان عليه السلام أعلم بما صنع، لما ذكرناه وبيّنا الوجه فيه وفصّلناه(1).
ص: 71
والمستفاد من مجموع السؤال والجواب: إنّ الظاهر من السؤال، هو ما أكّد المفيد على نفيه وهو دعوى «علم الأئمّة للغيب بلا واسطة». وهذا أمرٌ لم تقل به الشيعة، فضلاً عن أن تجمع عليه، لما قد ذكرنا في صدر هذه المقالة من أنّ علم الغيب بهذه الصورة خاصّ باللّٰه تعالى، ومستحيلٌ أن يكون لغيره من الممكنات. والممكن علمه من الغيب بالنسبة إلى النبيّ والأئمّة عليهم السلام هو الغيب بواسطة الوحي والإلهام من اللّٰه تعالى، وهذا لم ينفه المفيد.
والمجمع عليه - من هذا - بين الشيعة: إنّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون جميع الأحكام الشرعيّة بلا استثناء، لارتباط ذلك بمقامهم في الخلافة عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، كما أُثبت ذلك في علم الكلام. وأمّا غير الأحكام، فالظاهر من المفيد أنّه وضع ذلك في دائرة الإمكان ووقّفه على ورود الخبر والأثر به، فما قامت عليه الآثار قُبل والتزم به، وليس أصله مستحيلاً عقلاً ولا ممتنعاً من جهة آيةٍ أو سنّةٍ أو عقلٍ .
وهكذا قال في موضع «علم الأئمّة بمقاتلهم وما جرى عليهم»: فالتزم بعلم أمير المؤمنين عليه السلام بالمقدار الّذي جاءت به الأخبار، فما كان منها وارداً بالتفصيل التزم بعلمه له بالتفصيل، وما كان وارداً بالإجمال التزم بعلمه بالإجمال.
وقد نفى المفيد في الفصل الثاني الاعتراض على عليّ عليه السلام «بأنّه ألقى بنفسه إلى التهلكة إذا كان عالماً بوقت مقتله»، بأنّه عليه السلام على ذلك يكون مأموراً بتحمّل ذلك والصبر عليه والاستسلام له، لينال - بهذه الطاعة وهذا التسليم - المقامات الربّانية العالية المعدّة له، والّتي لا يبلغها إلّابذلك.
فليس المفيد رحمه الله في ردّ هذا الاعتراض مخالفاً لما التزمته الطائفة من «علم الإمام بمقتله، وإقدامه عليه بالاختيار» وإن ادّعى أنّ الآثار لم تنصّ على التفصيل، بل على مجرّد الإجمال.
والتفصيل بتعيين الساعة والوقت، وإن لم يذكر في الآثار، إلّاأنّ المعلوم من القرائن كون ذلك واضحاً ومتوقّعاً للإمام عليه السلام. ويظهر من هذا أنّ مجيء الأثر بذلك
ص: 72
- لو تمّ - لكان كافياً ووافياً للالتزام به، وعدم حاجة ذلك إلى القطع به، لما ذكرنا من أنّ ورود الأخبار - غير المعارضة ولا المنافية لأصلٍ ثابتٍ أو فرعٍ مقبولٍ - يكفي للالتزام في مثل هذه المواضيع، الّتي هي بحاجة إلى مقنعات متعارفة، دون حاجةٍ إلى مثبتاتٍ قطعيّةٍ ، أو حججٍ شرعيّة.
والقول بأنّ الأئمّة يعلمون الغيب بالإجمال دون التفصيل، قولٌ التزم به من الطائفة السيّد المرتضى وآخرون، وسنذكرهم أيضاً. إلّاأنّ المستفاد من مجموع كلام المفيد - وكذا الطوسي فيما سيأتي - أنّ الطائفة مجمعةٌ على أنّ النبيّ والأئمّة يعلمون الغيب - من اللّٰه وبوحيه وإلهامه - إمّا بالتفصيل أو بالإجمال، وليس في الطائفة من يُنكر علمهم هذا.
فالقول بنفي علم الغيب عنهم، مخالفٌ لإجماع الطائفة، كما أنّ الالتزام بعلمهم الغيب بالاستقلال منافٍ لعقائد الطائفة، ومعارض بآيات القرآن المطلقة الدالّة على اختصاص ذلك باللّٰه تعالى.
فقد ورد في السؤال البحث عن ثلاثة أُمور:
1 - عن علم الإمام عليه السلام بأنّ أهل الكوفة يخذلونه ولا ينصرونه.
2 - عن علمه عليه السلام أنّه مقتول في سفرته تلك.
3 - عن السبب في عدم حفره لتحصيل الماء.
والمفيد رحمه الله لم ينف علم الإمام بذلك كلّه، ولم يقل باستحالته وامتناعه، بل هو لم يُجب عن السؤال، ولعلّ سكوته كان من أجل ثبوته، لتظافر الأخبار المعلنة عن خبر مقتل الحسين عليه السلام ومكانه، بما لم يبق ريبٌ فيه للمخالفين، حتّى عدُّوه من دلائل النبوّة وشواهدها الثابتة، كما سيأتي بيانه.
وأمّا السؤال الأوّل: فقد نفى الشيخ المفيد قطعه هو به؛ لعدم قيام حجّة عليه عنده،
ص: 73
ولكنّه كما عرفت لم ينفه مطلقاً.
فيمكن أن يقال: إنّ عدم ثبوت حجّةٍ عند الشيخ، لا ينافي ثبوتها عند غيره، خصوصاً إذا لاحظنا إرسال السائل لذلك كالمسلّم. مع أنّ شواهد العلم بخذلان أهل الكوفة كانت واضحةً - من غير طريق علم الغيب - لكلّ ناظرٍ إلى أحداث ذلك اليوم ومجرياته، وقد تنبّأ بذلك أكثر المرويّ عنهم الكلام في هذا المقام، وفيهم من ليس من ذوي الاهتمام بهذه الشؤون، فكيف بالإمام الحسين عليه السلام الّذي كان محور الأحداث تلك ومدارها؟!
ثمّ إنّ افتراض المفيد لعلم الحسين عليه السلام بأنّه يُخذل ويُقتل، والجواب عن إقدامه على ذلك بالتعبّد، قرينةٌ واضحةٌ على إمكان العلم بذلك عنده، وأنّه أمرٌ ليس معارضاً للعقل ولا للكتاب، وإنّما لم يلتزم به لعدم ورود أثرٍ به عنده! فلو أثبتنا الحجّة على ورود الأثر بذلك بتواتر الآثار والأخبار، كفى دليلاً للالتزام به، وعدم قابليّة الاعتراض الثاني للوقوف في وجهه.
وكذلك أجاب المفيد عن الأمر الثالث بعدم قيام الحجّة عليه وعدم ورود أثرٍ به، مع مخالفته لمقتضى الحال وشواهده.
فقد صرّح المفيد رحمه الله بعلمه بمستقبل حال معاوية، ونكثه وثيقة الصلح، واستدلّ على ذلك بمجرّد مجيء الخبر به، ومطابقته لمقتضى الحال. فيدلّ على كفاية مثل ذلك لإثبات «علم الإمام بالغيب».
وأمّا الاعتراض بالإقدام على التهلكة:
فقد أجاب عنه بالمصلحة واللطف، ومقابلة ذلك بالأهمّ . فقد ظهر أنّ الشيخ المفيد رحمه الله لا يمنع من نسبة «علم الغيب» إلى الأئمّة إذا كان من طريق إعلام الوحي والإلهام لهم بواسطة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وأنّه في إثبات جزئيّات ذلك بحاجة إلى ورود
ص: 74
الأخبار والآثار بذلك، وأنّ شواهد الأحوال والسيرة تؤكّد إثبات ذلك أو نفيه عند المعارضة.
فرأي الشيخ المفيد في علم الأئمّة بالغيب هو: ثبوت ذلك لهم علماً مستفاداً، من دون كونه صفةً ذاتيّةً لهم، ولا وجوب عقليّ له، بل إنّما هو كرامة من اللّٰه لهم، وأنّ السمع قد ورد به. وقد نسب هذا القول إلى «جماعة أهل الإمامة» ولم يستثن إلّا شواذّاً من الغُلاة(1).
وقد أثبت في كتابه الإرشاد نماذج من الروايات الواردة في إخباراتهم الغيبيّة سواءً عن الماضيات أو المستقبلات، وحتّى عن أحوال المخاطبين وما يكنّونه في أنفسهم، ذكر ذلك في الدلالة على إمامة كلّ واحد من الأئمّة عليهم السلام في فصل أحواله.
فما نُسب إليه رحمه الله من أنّ الحسين عليه السلام لم يكن يعلم بمقتله، وأنّه إنّما توجّه إلى الكوفة بغرض الاستيلاء على المُلك، وأنّه لو كان عالماً بأنّه يُقتل لما ذهب؛ لأنّه إلقاءٌ في التهلكة!! كلّها نسبٌ باطلةٌ إلى الشيخ المفيد رحمه الله، لم تدلّ على ذلك عبارته المذكورة هنا الّتي استند إليها الناسبون، وبتروا وقطّعوا أوصالها، لتؤدّي ما يريدون!
الشيخ أبو جعفر، محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي (385-460 ه). قال السيّد بحر العلوم:
شيخ الطائفة المحقّة، رافع أعلام الشريعة الحقّة، إمام الفرقة بعد الأئمّة المعصومين، وعماد الشيعة الإماميّة في كلّ ما يتعلّق بالمذهب والدين، محقّق الأُصول والفروع، ومهذّب فنون المعقول والمسموع، شيخ الطائفة على الإطلاق، ورئيسها الّذي
ص: 75
تُلوى إليه الأعناق، صنّف في جميع علوم الإسلام، وكان القدوة في كلّ ذلك والإمام(1).
وقد عرض الشيخ الطوسي الاعتراض وأجاب عنه، وهذا نصّ ما ذكره:
فإن قيل: أليس في أصحابكم من قال: «إنّ الحسين عليه السلام كان يعلم ما ينتهي إليه أمره، وأنّه يُقتل ويخذله من راسله وكاتبه، وإنّما تعبّد بالجهاد والصبر على القتل»، أيجوز ذلك عندكم، أم لا؟!
وكذلك قالوا في أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّه كان يعلم أنّه مقتولٌ »، والأخبار عنه مستفيضةٌ به، وأنّه كان يقول: «ما يمنعُ أشقاها أن يخضبَ هذه من هذا»، ويومئ إلى لحيته ورأسه، وأنّه كان يقول تلك الليلة - وقد خرج وصحن الإوزُّ في وجهه -:
«إنّهنّ صوائحُ تتبعها نوائحُ ».
قالوا: «وإنّما أُمر بالصبر على ذلك»، فهل ذلك جائزٌ عندكم ؟!
قيل: اختلف أصحابُنا في ذلك:
فمنهم من أجاز ذلك(2) وقال: لا يمتنع أن يتعبّد بالصبر على مثل ذلك؛ لأنّ ما وقع من القتل - وإن كان ممّن فعله قبيحاً - فالصبر عليه حسنٌ ، والثواب عليه جزيلٌ . بل، ربّما كان أكثر، فإنّ مع العلم بحصول القتل - لا محالة - الصبر أشقُّ منه إذا جوّز الظفر وبلوغ الغرض.
ومنهم من قال: إنّ ذلك لا يجوز؛ لأنّ دفع الضرر عن النفس واجبٌ عقلاً وشرعاً، ولا يجوز أن يتعبّد بالصبر على القبيح، وإنّما يتعبّد بالصبر على الحسن، ولا خلاف أنّ ما وقع من القتل كان قبيحاً، بل من أقبح القبيح.
وتأوّل هذا القائل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من الأخبار الدالّة على علمه بقتله، بأن قال: كان يعلم ذلك على سبيل الجملة، ولم يعلم بالوقت بعينه، وكذلك علم
ص: 76
الليلة الّتي يُقتل فيها بعينها، غير أنّه لم يعلم الوقت الّذي يحدث فيه القتل.
وهذا المذهب هو الّذي اختاره المرتضى - رحمة اللّٰه عليه - في هذه المسألة.
ولي في هذه المسألة نظرٌ(1).
والّذي يستفاد من هذا النصّ سؤالاً وجواباً:
1 - إنّ الطائفة لم تختلف في أصل «أنّ الأئمّة يعلمون متى يموتون، وما يجري عليهم»، لكنّ المرتضى خالف في خصوص (الوقت المعيّن) للقتل، هل يعرفه الإمام بالتفصيل، أو يعرفه بالإجمال ؟ وأمّا العلم بحوادث أُخر فهو - أيضاً - مجمعٌ عليه، ولا خلاف فيه.
2 - إنّ الأخبار الّتي ظاهرها العلم بالتفصيل - حتّى بوقت الموت - متظافرةٌ وواردةٌ ، وإنّما القائل بالإجمال يحاول تأويلها!
3 - إنّ القائل بالإجمال إنّما صار إلى ذلك؛ لتصوّره أنّ أمراً مثل الإقدام على الشهادة أمرٌ لا يمكن التعبّد به؛ لأنّه قتلٌ قبيحٌ ، ولا تعبّد بالقبيح! وأنّ دفع الضرر واجبٌ عقلاً وشرعاً، فلا يجوز تركه على الإمام.
الأوّل: إنّ كون الفعل قبيحاً صدوراً من الفاعل، لا يقتضي كونه قبيحاً بالنسبة إلى الواقع عليه، فبالإمكان أن يفرض العمل قبيحاً صدوراً باعتبار حرمته على الفاعل أن يقوم به، ولكنّه يكون بالنسبة إلى القابل، أو الواقع عليه جائزاً مباحاً، أو مراداً.
فلا مانع من أن يكون قتل الأئمّة عليهم السلام حراماً على القاتلين، لكونه ظلماً وتعدّياً، بل من أقبح صوره وأفحشها، ولكن يكون الصبر على ذلك من الإمام أمراً حسناً لكونه؛ امتثالاً لأمر اللّٰه، وانقياداً لإرادته، ورضاً بقضائه، وتعبّداً بما عبّد به الإمام، لتحقيق
ص: 77
المصالح الدنيوية عليه، ولبلوغ الأئمّة المقامات العالية المفروضة لهم في ظرف طواعيّتهم وتحمّلهم لذلك.
الثاني: إنّه مع ورود النصّ بثبوت علم الأئمّة، لا وجه للجوء إلى مثل هذا التصوّر؛ لأنّ قبح القتل - في موارد - إنّما هو من جهة كونه ظلماً وحراماً؛ وكذا الإقدام على أن يقتل، والإلقاء إلى التهلكة إنّما يكون حراماً إذا كان منهيّاً عنه، أمّا إذا تعلّق به أمرٌ إلهيٌّ وصار مورداً للتعبّد به لمصلحة، فهو لا يكون قبيحاً للمتعبّد بذلك، والمفروض أنّ الأخبار قد وردت بذلك، فلا بدّ من فرض جوازه وحسنه.
كما كان الإقدام على الشهادة والقتل في سبيل اللّٰه، من أفضل القُرب وأشرفها، وأكثرها أجراً، وتستوجب أرفع الدرجات مع الصدّيقين.
الثالث: إنّ تحمّل القتل والصبر عليه في مثل هذا الفرض، لا يصحّ تسميته ضرراً، بل هو نفعٌ ، من أنفع ما يقدم عليه عباد اللّٰه المخلصون، ويختارونه؛ لكونه لقاء اللّٰه، ومقرّباً إليه، ولما يترتّب على ذلك من المصالح للإسلام وللأُمّة، ولأنّه محقّقٌ أروع الأمثلة للتضحية والفداء في سبيل الأهداف الإلهيّة الكبيرة والجليلة. فلا حرمة فيه شرعاً ولا عقلاً، بل هو محبوبٌ وواجبٌ في بعض الأحيان.
4 - وقد دلّ هذا النصّ على أنّ المتفرّد بالقول بالإجمال إنّما هو السيّد المرتضى، وأنّ القائل بالإجمال يعارض التعبّد بالصبر على ذلك، فظهر أنّ المفيد - الّذي مرّ افتراضه للتعبّد - إنّما يفترض ذلك على تقدير التفصيل، وأنّ القول بالإجمال ليس بحاجةٍ إلى افتراض ذلك.
ثمّ إنّ مما يؤكّد جواز إقدام الإمام عليه السلام على الأخطار مع علمه بها، هو مبيت أمير المؤمنين عليّ عليه السلام على فراش النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ليلة هجرته من مكّة إلى المدينة فادياً له
ص: 78
بنفسه، حتّى نزلت فيه آية: «وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اَللّٰهِ ...»(1) ، وقد كان ذلك بأمر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فتوجّه هو إلى الغار، وأنام عليّاً على فراشه وألبسه بُرده(2).
فقال عليّ عليه السلام في ذلك شعراً(3):
وقيت بنفسي خير من وطِئ الحصى *** ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر
وبتُّ أُراعي منهُم ما ينُوبُني *** وقد صبرت نفسي على القتل والأسر
ولم يكن يخفىٰ على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ما يتهدّد الإمام عليه السلام من الخطر، فكيف أمره بالمبيت وأنامه على فراشه ؟!
وما كان يخفىٰ على عليّ عليه السلام خطر القتل والأسر، فكيف تعبّد بذلك وأطاع ؟!
وقول قيل: إنّهما كانا يعلمان عدم إصابته بأذىً في ذلك، فهو إثبات لعلم الغيب الّذي يحاول إنكاره، مع أنّه قد كان القتل محتملاً كما قال اللّٰه تعالى: «وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ »(4) ، وكما احتمله الإمام عليّ عليه السلام في شعره المذكور؟!
ثمّ إنّ للشيخ الطوسي كلاماً حول أعذار الحسين عليه السلام في مخرجه ومقتله، ذكره في تلخيص الشافي، وهو بعين العبارة مذكورٌ في كتاب تنزيه الأنبياء للسيّد المرتضى، فلا بدّ من ذكره، سؤالاً وجواباً؛ لارتباطه الوثيق بهذا المبحث:
فإن قيل: فما أعذار الحسين عليه السلام ؟! لأنّه خرج بأهله وعياله إلى الكوفة، والمستولي عليها أعداؤه والمتأمّر فيها من قبل يزيد منبسط اليد والأمر والنهي، وقد رأى صنيع
ص: 79
أهل الكوفة بأبيه وأخيه عليهما السلام وأنّهم غادرون خوّانون ؟!
وكيف خالف ظنُّه ظنّ جميع أصحابه؛ لأنّ ابن عبّاس - رحمة اللّٰه عليه - أشاربالعدول عن خروجه، وقطع على العطب، وابن عمر لمّا ودّعه يقول: أستودعك اللّٰه من قتيل، وأخوه محمّد مثل ذلك، إلى غير من ذكرناه ممّن تكلّم في هذا الباب ؟!
ثمّ لمّا علم بقتل مسلم بن عقيل - وقد أنفذه رائداً له - كيف لم يرجع، ويعلم الغدر من القوم، وتفطّن بالحيلة والمكيدة ؟! ثمّ كيف استجاز أن يحارب بنفرٍ قليلٍ ، لجموعٍ عظيمةٍ خلفها موادّ لها كثيرةٌ؟! ثمّ لمّا عرض عليه ابن زياد الأمان وأن يبايع يزيد، كيف لم يستجب حقناً لدمه ودماء من معه من أهله وشيعته ومواليه ؟! ولم ألقى بيده إلى التهلكة ؟!
وبدون هذا الخوف سلّم أخوه الحسنُ عليه السلام الأمر إلى معاوية ؟!
وقد أجابا عن جميع ما ورد في السؤال بتفصيل، ونحن نقسّمه إلى مقاطع؛ لتسهيل الإرجاع إليها.
1 - قد علمنا أنّ الإمام متىٰ غلب على ظنّه أنّه يصل إلى حقّه والقيام بما فُوّض إليه - بضربٍ من الفعل - وجب عليه ذلك، وإن كان فيه ضربٌ من المشقّة يُتحمّل مثلها، تحمّلها.
وأبو عبد اللّٰه عليه السلام لم يسر إلى الكوفة إلّابعد توثّقٍ من القوم وعهودٍ وعقودٍ، وبعد أن كاتبوه عليه السلام طائعين غير مكرهين، ومبتدئين غير مجيبين.
وقد كانت المكاتبة من وجوه أهل الكوفة وأشرافها وقرّائها، تقدّمت إليه عليه السلام في أيّام معاوية، وبعد الصلح الواقع بينه وبين الحسن عليه السلام، فدفعهم وقال في الجواب ما وجب.
ثمّ كاتبوه بعد وفاة الحسن عليه السلام - ومعاوية باقٍ - فوعدهم ومنّاهم. وكانت أيّام
ص: 80
معاوية صعبةً لا يُطمع في مثلها، فلمّا مضى معاوية أعادوا المكاتبة وبذل الطاعة، وكرّروا الطلب والرغبة، ورأى عليه السلام من قوّتهم - على من كان يليهم في الحال من قبل يزيد وتسلّحهم عليه وضعفه عنهم - ما قوّى في ظنّه أنّ المسير هو الواجب، وتعيّن عليه فعله.
2 - ولم يكن في حسابه أنّ القوم يغدر بعضهم، ويضعف بعضهم عن نصرته، ويتّفق ما اتّفق من الأُمور الطريفة الغريبة... أنّ أسباب الظفر بالعدوّ كانت لائحةً ، وأنّ الاتّفاق السيّئ هو الّذي عكس الأمر وقلبه حتّى تمّ فيه ما تمّ .
3 - وقد همّ أبو عبد اللّٰه عليه السلام لمّا عرف بقتل مسلمٍ وأُشير عليه بالعود، فوثب إليه بنو عقيلٍ فقالوا: واللّٰه، لا ننصرف حتّى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا. فقال عليه السلام: «لا خيرَ في العيشِ بعدَ هؤلاء».
4 - ثمّ لحقه الحرُّ بن يزيد ومن معه من الرجال... ومنعه من الانصراف، وسامه أن يقدم على ابن زياد، نازلاً على حكمه، فامتنع، ولمّا رأى ألّا سبيل إلى العود، ولا إلى دخول الكوفة، سلك طريق الشام سائراً نحو يزيد؛ لعلمه عليه السلام بأنّه - على ما به - أرقّ به من ابن زياد وأصحابه! فسار حتّى قدم عليه عمر بن سعد في العسكر العظيم، وكان من أمره ما قد ذُكر وسُطر.
فكيف يقال: إنّه عليه السلام ألقى بيده إلى التهلكة ؟! وقد روي أنّه عليه السلام قال لعمر بن سعد:
اختاروا منّي: إمّا الرجوعَ إلى المكان الّذي أقبلتُ منه، أو أن أضع يديَّ على يد يزيد فهو ابن عمّي يرى فيَّ رأيه، وإمّا أن تسيروا بي إلى ثغرٍ من ثُغور المسلمين، فأكون رجلاً من أهله، لي ما لهُ ، وعليَّ ما عليه.
وإنّ عمر كتب إلى عبيداللّٰه بن زياد بما سأل، فأبى عليه، وكاتبه بالمناجزة، وتمثّل بالبيت المعروف، وهو:
الآن إذ علقت مخالبُنا به *** يرجُو النجاة ولات حين أوان
فلمّا رأى عليه السلام إقدام القوم، وأنّ الدين منبوذٌ وراء ظهورهم، وعلم أنّه إن دخل
ص: 81
تحت حكم ابن زياد تعجّل الذُلّ والعار، وآل أمرُه - من بعد - إلى القتل، التجأ إلى المحاربة والمدافعة لنفسه، وكان بين إحدى الحسنيين: إمّا الظفر، أو الشهادة والميتة الكريمة.
5 - وأمّا مخالفة ظنّه لظنّ جميع من أشار عليه من النصحاء - كابن عبّاس وغيره - فالظنون إنّما تغلب بحسب الأمارات، وقد تقوّى عند واحدٍ، وتضعف عند آخر، ولعلّ ابن عبّاس لم يقف على ما كوتب عليه السلام به من الكوفة، وما تردّد في ذلك من المكاتبات والمراسلات والعهود والمواثيق.
6 - فأمّا محاربة الكثير بالنفر القليل، فقد بيّنا أنّ الضرورة دعت إليها، وأنّ الدين والحزم معاً ما اقتضيا في هذه الحال إلّاما فعل.
7 - وليس يمتنع أن يكون عليه السلام في تلك الحال مجوّزاً أن يفيء إليه قومٌ ممّن بايعه وعاهده ثمّ قعد عنه، ويحمله ما يرون - من صبره وعدم استسلامه، وقلّة ناصره - على الرجوع إلى الحقّ ، ديناً أو حميّةً ، فقد فعل ذلك نفرٌ منهم حتّى قُتلوا بين يديه عليه السلام شهداء. ومثل هذا يُطمع فيه، ويُتوقّع في أحوال الشدّة.
8 -... والحسين عليه السلام لمّا قوي في ظنّه النصرة ممّن كاتبه ووثق له، فرأى من أسباب قوّة نصّار الحقّ وضعف نصّار الباطل، ما وجب معه عليه الطلب والخروج.
فلمّا انعكس ذلك، وظهرت أمارات الغدر فيه وسوء الاتّفاق، رام الرجوع والمكافّة والتسليم، كما فعل أخوه عليه السلام، فمُنع من ذلك، وحيل بينه وبينه(1).
أقول: لا بدّ من تفسير ما ورد في هذا النصّ - سؤالاً وجواباً - من عبارة «كيف خالف ظنّه ظنّ جميع أصحابه» في السؤال، وعبارة «غلب على ظنّه» و «قوّى في ظنّه» في الفقرة الأُولى من الجواب، وعبارة «وأمّا مخالفة ظنّه لظنّ جميع من أشار
ص: 82
عليه» في الفقرة الخامسة، وعبارة «لمّا قوي في ظنّه النصرة» في الفقرة الثامنة.
حيث أُضيفت كلمة «الظنّ » إلى الإمام عليه السلام وهي ظاهرة في إرادة حالة الشكّ والتردّد، خصوصاً بقرينة كلمات «غلب» و «قوى» و «قوي» وقياسه بظنون الآخرين.
وهذا بلا شكّ ، يُعطي الموافقة على أنّ الإمام عليه السلام لم يكن متأكّداً بصورةٍ علميّةٍ ممّا يُقدم عليه.
فلا بدّ إذن من توجيه لهذا الإطلاق، فأقول: بما أنّ المرتضى والطوسي استعملا في الجواب كلمة «الظنّ » في مورد الحكم الشرعيّ ، حيث قالا في الفقرة الأُولى:
«متى غلب على ظنّه أنّه يصل إلى حقّه... بضرب من الفعل وجب عليه ذلك»، وفي الفقرة الثامنة: «لمّا قوي في ظنّه النصرة... ما وجب معه عليه الطلب والخروج».
وهذا «الوجوب» حكم شرعي.
وقد عرفنا فيما نقله المفيد إجماع الطائفة على أنّ الإمام يعلم الأحكام كلّها، ولا يعتمد فيها على مجرّد «الظنّ »، حيث قال المفيد: «وإنّما إجماعهم ثابت على أنّ الإمام يعلم الحكم في كلّ ما يكون» وكذلك قال: «وعلى ذلك جماعة أهل الإمامة» في إثبات علم الأئمّة بالغيب المستفاد من اللّٰه تعالى، واستثنى الغُلاة.
وكذلك ما حصل من حصر الطوسي أقوال الطائفة في مسألة علم الأئمّة بالغيب بين قولين فقط، ولم يختلفا في أصل علم الأئمّة بالغيب، وإنّما اختلفا في معرفة «وقت القتل» بين التفصيل والإجمال، واتّفقا على العلم بغير ذلك بالتفصيل، فإنّه يقتضي أن يكون الإمام عالماً بالأحكام.
كما عرفت أنّ الطوسي نسب القول بالعلم الإجمالي بوقت القتل إلى خصوص المرتضى، ممّا يقتضي عدم مخالفته للطائفة في التزام العلم في غير هذا، ومنه الأحكام.
كما أنّ استدلال الكلاميين من الطائفة على ثبوت علم الإمام بالأحكام وضرورة
ص: 83
ذلك معروفٌ في كتب الكلام. ومع كلّ هذا، فكيف يمكن أن يريد الطوسي والمرتضى مجرّد الشكّ والاحتمال - ولو الاحتمال الراجح - من كلمة «الظنّ »؟! فلا بدّ أن يكون المراد بالظنّ ليس ما يقابل اليقين، بل يراد به هو «اليقين».
وقد استُعمل «الظنّ » وأُطلق على «اليقين» لغةً ، وصرّح علماء اللغة بذلك:
قال الجوهري:
الظنّ : معروفٌ ، وقد يوضع موضع العلم.
وقال الأزهري:
الظنّ : يقين، وشكّ .
وقال ابن سيده:
الظنّ : شكّ ويقين، إلّاأنّه ليس بيقين عيانٍ ، إنّما هو يقين تدبّر(1).
فإذا كان المراد بالظنّ هو اليقين، فالمعنى: إنّ الإمام عليه السلام لمّا علم بأنّ الفعل هو الواجب عليه حسب الظروف المعيّنة الّتي تحيط به، فهو عالمٌ بما يقوم به، في صلحه وسلمه، وفي خروجه وحربه.
والإمام الحسين عليه السلام كان على علمٍ ويقينٍ بأنّ حركته هي إعلان عن حقّه في قيادة المسلمين الّتي آلت إليه في تلك الظروف، وأنّه بخروجه وقيامه يملأ الثغرة الّتي كادت الدولة الأُمويّة أن توسّعها بعدما أحدثتها، والضربة القاضية الّتي كاد يزيد أن يوقعها بالأُمّة الإسلاميّة والدين الإلٰهي، بعد أن أنهكهما أبوه طعناً، فكانت حركة الإمام الحسين عليه السلام سدّاً منيعاً يصدّ الجاهلية أن تعود إلى الحياة.
ويدلّ على أنّ مراد السيّد المرتضى والشيخ الطوسي إثبات «علم الإمام بما يجري» قولُهما في آخر الفقرة الرابعة: «فلمّا رأى عليه السلام إقدام القوم، وأنّ الدين منبوذٌ وراء ظهورهم، وعلم أنّه إن دخل تحت حكم ابن زياد تعجّل الذلّ ...». فإذا كان
ص: 84
الحسين عليه السلام علم هذا، فأجدر به أن يعلم غيره ممّا جرىٰ !.
وأمّا قولهما في الفقرة الثانية: «ولم يكن في حسابه أنّ القوم يغدر بعضُهم...»، فمعناه: إنّ احتمالات الغدر والخيانة وطروء الظروف غير المنظورة، أُمور لا تدخل في الحساب؛ لأنّها تخميناتٌ لا يمكن الاعتماد عليها لمن يُقدم على مثل ما أقدم عليه الإمام الحسين عليه السلام في الخُطورة والأهمّية، وفي النتائج العظيمة والوخيمة الّتي كانت تترتّب عليه إيجاباً وسلباً.
فالإمام الحسين عليه السلام بنى حركته على أساس من علمه بوجوبها عليه، وعلمه بما يترتّب عليها من النتائج، وما يجب أن يتحمّله من المآسي والآلام، فلا يمنعه الاحتمال ولا تدخل في حسابه التخمينات، ولم يأبه بما يُثار في هذه الطريق من الأخطار، إذ لا يُنقض يقينُه بيقين أحدٍ من الناس العاديّين، فكيف بظنونهم واحتمالاتهم ؟!.
إنّ الحسين عليه السلام كان يعمل ويسير من منطلق العلم بالحكم الشرعيّ المحدّد له في مثل ظرفه، والواضح له من خلال تدبّر مصالح الإسلام والمسلمين، والمعروف له من بوّابة الغيب المتّصلة بطرق السماء من خلال الوحي النبويّ والإلهام الّذي عرفه بإخبار جدّه النبيّ وأبيه عليّ عليهما السلام فكان يرى كلّ شيء رأي العين، ويسير بثباتٍ ويقينٍ ، ولم يكن ليصرفه عن واجبه الإلهيّ المعلوم له، كلّ ما يعرفه من غدر الكوفة وخيانة أهلها، فكيف ينصرف باحتمال غدرهم وظنّ خيانتهم ؟!
وقد شرحنا في كتابنا الحسين عليه السلام سماته وسيرته جانباً من هذه الحقيقة، في ذكر مواجهة الإمام الحسين عليه السلام لجواب الناصحين له بعدم الخروج، والمتنبّئين بأنّ مصيره «القتل» فكان الجواب الحاسم:
إنّ الحسين عليه السلام إذا كان خارجاً لأداء واجب الدعوة إلى اللّٰه، فلا يكون خروجُه لغواً، ولا يحقّ لأحدٍ أن يُعاتبه عليه؛ لأنّه إنّما يؤدّي بإقدامه واجباً إلهيّاً، وضعه اللّٰه على الأنبياء وعلى الأئمّة من قبل الحسين عليه السلام ومن بعده.
ص: 85
وإذا أحرز الإمام تحقّق شروط ذلك، وتمّت عنده العُدّة - ولو الظاهريّة - للخروج، من خلال العهود والمواثيق ومجموعة الرسائل والكتب الّتي وصلت إليه، فهو لا محالة خارجٌ ، ولا تقف أمامه العراقيل المنظورة له والواضحة، فضلاً عن تلك المحتملة والقائمة على الفرض والتخمين، مثل الغدر به، أو قتله وهلاكه! ذلك الّذي عرضه الناصحون.
فكيف لو كان المنظور هو الشهادة والقتل في سبيل اللّٰه، الّتي هي من أفضل النتائج المتوقّعة والّتي يترقّبها الإمام، والمطلوبة لمن يدخل هذا السبيل، ويسير في هذا الطريق الشائك ؟
مع أنّ الشهادة مقضيّةٌ له وهو مأمورٌ بها، ويحتاج إلى توفيق عظيم لنيلها، فهي إذن من صميم الأهداف الّتي كان يضعها الإمام الحسين عليه السلام نصب عينيه، ويسعى لطلبها، لا أنّها موانع في طريق إقدامه!
وأمّا أهل العراق وسيرتهم، وأنّهم أهل النفاق والشقاق، وعادتُهم الغدر والخيانة، فهي أُمورٌ لا تعرقل خطّة الإمام في قيامه بواجبه؛ وإن كان فيها ضررٌ متصوّرٌ، فهي على حياة الإمام، وتمسّ راحته، وليس هذا مهمّاً في مقابل أمر القيادة الأهمّ ، وأداء واجب الإمامة الإلٰهي، ولا في أمر الشهادة حتّى يتركها من أجل ذلك.
ولذلك لم يترك الإمام علي عليه السلام أهل الكوفة بالرغم من إظهاره استياءه منهم إلى حدّ الملل والسأم! لأنّ الإمام لا يجوز له - شرعاً - أن يترك موقع القيادة، وواجب الإمامة من أجل أخلاق الناس المؤذية.
وكذلك الواجب الّذي أُلقي على عاتق الإمام الحسين عليه السلام بدعوة أهل العراق وأهل الكوفة بالخروج إليهم والقيام بقيادة أمرهم وهدايتهم إلى الإسلام، لم يتأدّ إلّا بالخروج، ولم يسقط هذا الواجب بمجرّد احتمال العصيان غير المتحقّق، في ظاهر الأمر، فكيف يرفع اليد عنه، وما هو عذرُه عن الحجّة الّتي تمّت عليه بدعوتهم ؟! ولم يبد منهم نكثٌ وغدرٌ به ؟! فلابدّ أن يمضي الإمام في طريق أداء واجبه، حتّى تكون له الحجّة عليهم، إذا خانُوا وغدرُوا، كما حدث في كربلاء، ولو كان على حساب وجوده الشريف(1).
ص: 86
وقلت فيه أيضاً:
وغريبٌ أمر أُولئك الّذين ينظرون إلى الموقف من زاوية المظاهر الحاضرة، ويحذفون من حساباتهم الأُمور غير المنظورة، ويريدون أن يحاسبوا حركة الإمام وخروجه على أساس أنّه إمامٌ عالمٌ بالمصير، بل لا بدّ أن يعرف كلّ شيءٍ من خلال الغيب! فكيف يُقدم على ما أقدم، وهو عالمٌ بكلّ ما يصير؟!
والغرابة في أنّ الإمام الحسين عليه السلام لو عمل طبقاً لما يعلمه من الغيب، لعاب عليه كلُّ من يسمع الأخبار، ويقرأ التاريخ: إنّه ترك دعوة الأُمّة المتظاهرة بالولاء له، من خلال آلاف الكتب والعهود - والواصلة إليه بواسطة أُمناء القوم ورؤسائهم - إنّه تركهم استناداً إلى احتمالات الخيانة والتخاذل، الّتي لم تظهر بوادرُها إلّا بالتخمين، حسب ماضي هذه الجماعة وأخلاقهم.
فلو عمل الإمام بعلمه بالغيب، الّذي لم يؤمن به كثيرٌ من الناس في عصره ومن بعده، ولم يسلّمه له غير مجموعة قليلة من شيعته، ولو أطاع أُولئك الناصحين له بعدم الخروج، لكان مُطيعاً لمن لم تجب عليه طاعتُهم، وتاركاً لنجدة من تجب عليه نجدتُهم.
كما أنّ طاعة أُولئك القلّة من الناصحين، لم تكن بأجدر من طاعة الآلاف من عامّة الشعب، الّذين قدّموا له الدعوة وبإلحاحٍ ، وقدّموا له الطاعة والولاء. وقبل هذا وبعده، فإنّ الواجب الإلهيّ يحدُوه، ويرسم له الخطط للقيام بأمر الأُمّة، فإذا تمّت عليه الحجّة بوجود الناصر، فهذا هو الدافع الأوّل والأساسيّ للإمام على الإقدام، دون الإحجام على أساس الاحتمالات السياسيّة والتوقّعات الظاهريّة.
وإنّما استند إليها في نصوصٍ من كلماته وتصريحاته؛ لإبلاغ الحجّة، وإفحام الخصوم، وتوضيح المحجّة لكلّ جاهلٍ ومظلومٍ (1).
إنّ حاصل ما ذكره السيّد المرتضى والشيخ الطوسي في أمر الحسين عليه السلام هو:
إنّه عليه السلام علم بواجبه وتيقّن بتماميّة الحجّة، بدعوة أهل العراق وتواتر كتبهم إليه وطلبهم
ص: 87
له، واستقرّ عليه هذا الواجب، فنهض لأداء واجبه، وخرج إليهم ليُتمّ هو الحجّة عليهم، وهو وإن كان عالماً بالنتيجة المعلومة له من الغيب أو من شواهد الحال، إلّا أنّه لم تقم حجّةٌ خارجيّةٌ عياناً تردّ الحجّة الّتي قدّمها أهل الكوفة بدعوتهم للإمام، إلّا بعد حصر الإمام في كربلاء.
والإمام لم يُكلّف - قبل كربلاء - بالعمل بواجبه الظاهر، ولو أخبر - هو - بما يعلمه من الغيب، هل كان يصدّقه أحدٌ؟ خصوصاً من أهل الكوفة الّذين دعوه ؟ وبالأخصّ قبل أن يظهر منهم الغدر، وقبل أن يُحاط بالإمام في كربلاء؟
وأمّا في كربلاء، فإنّ الأمر قد اختلف، وقد تمّت الحجّة على أهل الكوفة بحضور الإمام، وبظهور الغدر والخيانة منهم! وكان واجب الإمام هو حفظ كرامته وحرمته، وكرامة الإسلام وحرمته الّتي ستُهتك وتُهدر باستسلامه.
مع أنّ مصيره المعلوم كان هو القتل حتّى بعد الاستسلام! وكما قال الشيخ الطوسي والسيّد المرتضى - بنصّ العبارة - في الفقرة السادسة: «فإنّ الضرورة دعت إليها - أي المحاربة - وإنّ الدين والحزم معاً ما اقتضيا - في هذه الحال - إلّاما فعل».
فبعد إتمام الإمام عليه السلام الحجّة بما قام به من الخروج والمسير إلى أهل الكوفة، وحتّى عرضه عليهم الصلح والسلام - وبكلّ خياراته وأشكاله - ورفضهم لها كلّها، تمّت الحجّة عليهم، فحاربهم وقاومهم وجاهدهم، وناضلهم، حتّى نال الشهادة.
ومن المخزي أنّ بعض المتطفّلين على العلم والدين، والقلم والكتابة، اتّبع ما تشابه من عبارات الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الطوسيّ ، فاستشهد بظواهرها - ومن دون بحثٍ وتحقيقٍ عن الأعماق والدلالات المرادة فيها - على ما وضعه نصب عينه من نفي علمهم بالغيب، يحاول إثباته والتأكيد عليه بصورٍ مختلفة:
فتارةً : بدعوى أنّ الحسين عليه السلام لم يكن يعلم بما وقع عليه من القتل والبلاء، وإنّما خرج طالباً للحكم والسلطان والملك والخلافة! ولكنّه فوجئ بجيشٍ أقوى ممّا معه، وبغدر من وعده النصر وخذلانه، وانقلب الأمر عليه!
ص: 88
وبدعوى: أنّه ما كان يريد أن يُقتل، وأنّه كان في خروجه يأمل النصر ويتوقّعه، ولذلك عرض على جيش الكوفة عروضاً سلميّة!
وأُخرى بدعوى: أنّه لم يقم إلّامُنطلقاً من خلال العناوين الفقهيّة العامّة، من دون أن يكون لخصوصيّة إمامته دخلاً في خُروجه وحركته!
إنّ هؤلاء لو جرّدوا الحسين عليه السلام عن قُدسيّة الإمامة الّتي قلّده اللّٰه بها، وسلبوا عنه علم الإمام بالغيب حتّى الحكم الشرعيّ ومعرفة ما يجب عليه أن يفعل! فلماذا جرّدوه وسلبوه من التنبّه لما عرفه أُناسٌ عاديّون عاصروا الأحداث - مثل الفرزدق، وابن عبّاس، وابن عمر، وحتّى بعض النساء - الّذين أعلنوا أنّ ذهابه إلى العراق يؤدّي إلى قتله ؟!
ولماذا فرضُوا أنّ الحسين عليه السلام لم ير ما رآه أُولئك برؤيةٍ واضحةٍ؟! وقد أبلغوه آراءهم ورُؤاهم، فهلّا تنبّه - لو فرضت له غفلة - أنّ هؤلاء ينزلون بالحسين إلى مرتبةٍ أقلّ من إنسانٍ عاديّ عاصر الأحداث!
وكيف لهم أن يُعرضوا - بغمضة عينٍ - عن عشرات الآثار والروايات والأخبار والأحاديث، وفيها الصحيح والمسند والمتّصل، وذات الدلالات الواضحة، والّتي مُلئت بها كتب السيرة والحديث والتاريخ، والّتي أخبرت عن «مقتل الحسين ومصرعه في كربلاء»، وعلى لسان النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وعليّ أمير المؤمنين عليه السلام ؟!
تلك الأخبار الّتي عُدّت من «دلائل النبوّة» و «معجزات الإمامة» والّتي احتجّ بها المسلمون، وتواتر خبرها بينهم، فأخبرت عن «قتل الحسين في كربلاء» قبل مولده وعنده وبعده، وقد أحضر الرسول تربة مصرعه وشمّها، وحضر عليٌّ أرض كربلاء، وصبّر أبا عبد اللّٰه فيها وهو في طريق صفّين ذهاباً وإيّاباً.
وهل يتصوّرون أنّ هذه الأخبار خفيت عن الحسين نفسه وقد علمها غيره ؟!
ص: 89
هو الشيخ أبو جعفر، محمّد بن عليّ بن شهر آشوب ابن أبي نصر، السروي المازندراني، رشيد الدين.
قال الصفدي:
أحد شيوخ الشيعة، حفظ القرآن وله ثمان سنين.
قال ابن أبي طيّ الحلبي:
اشتغل بالحديث، ولقي الرجال، ثمّ تفقّه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت، ونبغ في الأُصول، ثمّ تقدّم في القراءات والقرآن، والتفسير، والعربيّة.
وكان مقبول الصورة، مليح العرض على المعاني، وصنّف في: المتّفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف، والفصل والوصل، وفرّق بين رجال الخاصّة ورجال العامّة.
كان كثير الخشوع، مات في شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمئة.
وقال الصفديّ : بلغ النهاية في أُصول الشيعة، كان يرحل إليه من البلاد، ثمّ تقدّم في علم القرآن، والغريب، والنحو.
ووعظ على المنبر أيّام المقتفي ببغداد، فأعجبه وخلع عليه، وأثنى عليه كثيراً.
وقال الداوودي في طبقات المفسّرين:
كان إمام عصره، وواحد دهره، أحسن الجمع والتأليف، وغلب عليه علم القرآن والحديث، وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي لأهل السُنّة في تصانيفه، وتعليقات الحديث ورجاله ومراسيله، ومتّفقه ومفترقه، إلى غير ذلك من أنواعه.
واسع العلم، كثير الفنون، قال ابن أبي طيّ : ما زال الناس بحلب لا يعرفون الفرق بين «ابن بطّة» الحنبلي، و «ابن بُطّة» الشيعي، حتّى قدم الرشيد، فقال: «ابن بطّة الحنبلي بالفتح، والشيعي بالضمّ (1).
ص: 90
وقد تعرّض للمشكلة في ذيل آية: «... وَ لاٰ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ ...» من الآية (31) من سورة هود، فقال:
النبيّ والإمام يجب أن يعلما علوم الدين والشريعة، ولا يجب أن يعلما الغيب، وما كان وما يكون؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى أنّهما مشاركان للقديم تعالى في جميع معلوماته، ومعلوماته لا تتناهى، وإنّما يجب أن يكونا عالمين لأنفسهما، وقد ثبت أنّهما عالمان بعلم محدثٍ .
والعلم لا يتعلّق - على التفصيل - إلّابمعلومٍ واحدٍ، ولو علما ما لا يتناهى، لوجب أن يعلما وجود ما لا يتناهى من المعلومات، وذلك محالٌ . ويجوز أن يعلما الغائبات والكائنات الماضيات، والمستقبلات، بإعلام اللّٰه تعالى لهما شيئاً منها.
وما روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم أنّه مقتولٌ ، وأنّ قاتله ابن ملجم، فلا يجوز أن يكون عالماً بالوقت الّذي يقتله فيه على التمييز؛ لأنّه لو علم ذلك لوجب عليه أن يدفعه عن نفسه، ولا يُلقي بيده إلى التهلكة! وأنّ هذا - في علم الجملة - غير واجبٍ (1).
إنّ ما أثبته الشيخ ابن شهر آشوب موافقٌ لما سبق ذكره سوى نقطة واحدة: فما ذكره من نفي «علم الغيب بالاستقلال» عن الأئمّة، مجمعٌ عليه بين المسلمين؛ وذلك لما ذكرنا في صدر هذا البحث من دلالة الآيات الكريمة على اختصاص ذلك باللّٰه تعالى.
مضافاً إلى ما ذكره ابن شهر آشوب من الاستدلال العقلي بأنّ النبيّ والإمام محدود متناهٍ ، والغيب لا حدّ له، ولا يمكن أن يحيط المحدود باللّامنتهي. ثمّ ما ذكره من إمكان علم الغيب بإعلام اللّٰه تعالى: هو أيضاً ممّا أجمعت عليه الطائفة، ودلّت عليه الآيات الكريمة الّتي ذكرناها في صدر البحث.
وأمّا التفرقة بين علم الإمام بالحوادث، وخصوصاً ما يرتبط بقتله، من الالتزام
ص: 91
بالتفصيل في غير وقت القتل، والالتزام بالإجمال فيه، فهذا أيضاً قد سبق قول المرتضى فيه والتزامه.
وقد أضاف ابن شهر آشوب تصريحاً بأنّه على فرض علم الإمام بوقت قتله بالعلم الإجمالي، فلا يرد عليه اعتراض الإلقاء في التهلكة؛ لأنّ الدفع حينئذٍ غير واجب لفرض الإجمال فيه وعدم معرفته بالتفصيل.
وإنّما اختّص ابن شهر آشوب بالتزامه بالاعتراض على تقدير علم الإمام بوقت قتله تفصيلاً، فقال: «فلا يجوز أن يكون عالماً بالوقت الّذي يقتله فيه على التمييز؛ لأنّه لو علم ذلك لوجب عليه أن يدفعه عن نفسه، ولا يلقي بيده إلى التهلكة».
وهذه هي النقطة الّتي خالف فيها ابن شهر آشوب من سبقه؛ لأنّ الشيخ المفيد الّذي أشار إلى مسألة علم الجملة، قال بإمكان القول بالتفصيل، ومنع كون ذلك من الإلقاء في التهلكة، لإمكان التعبّد بالصبر على القتل للإمام.
وحتّى السيّد المرتضى - الّذي التزم بالجملة، ونفى التعبّد - لم يصرّح بالتزامه اعتراض الإلقاء في التهلكة على تقدير التفصيل، فلعلّه دفعه بأحد الوجوه الكثيرة المتصوّرة، والّتي يكون تحمّل القتل بها أمراً حسناً أيضاً ولو بغير التعبّد!
ولعلّ ابن شهر آشوب عدّ فقدان الإمام ضرراً وتهلكةً ، فحكم فيه بوجوب الدفع وعدم الإلقاء؛ محافظةً على وجوده الشريف لأداء مهمّات الإمامة.
لكنّ إطلاق لفظ «الضرر» ولفظ «التهلكة» على ما جرى على الإمام ممنوعٌ مطلقاً؛ فإنّه إذا علم الإمام إرادة اللّٰه تعالى لما يجري عليه، مع أنّه يعلم ما فيه من المصلحة للدين والأُمّة، والمصلحة لنفسه الشريفة بالفوز بالشهادة ورفع الدرجات والكرامة الإلهيّة، بانقياده المطلق لأوامر اللّٰه تعالى، وتسليمه المطلق للّٰه، ورضاه بما يرضاه تعالى، فلا ريب أن لا يكون فيما يُقدم عليه أيّ ضررٍ، ولا يمكن أن يسمّىٰ ذلك تهلكةً بأيّ وجهٍ ، إلّافي المنظار المادّي والدنيوي.
ونظرة إلى قصّة إبراهيم، وولده الذبيح إسماعيل عليهما السلام الّتي جاءت في القرآن
ص: 92
الكريم، حين أمر اللّٰه إبراهيم بذبح ابنه، فقال تعالى في نهايتها: «فَلَمّٰا أَسْلَمٰا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَ نٰادَيْنٰاهُ أَنْ يٰا إِبْرٰاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ اَلرُّؤْيٰا إِنّٰا كَذٰلِكَ نَجْزِي اَلْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هٰذٰا لَهُوَ اَلْبَلاٰءُ اَلْمُبِينُ »(1) ... فقد سمّى اللّٰه ذلك تسليماً، وتصديقاً، وإحساناً، وجعله «بلاءً مُبيناً» مع أنّه لم يتحقّق فيه ذبحٌ ، بل فُدي إسماعيل بذبحٍ عظيمٍ .
فإذا لم يكن ما جرى على إسماعيل إلقاءً في التهلكة وكان أمراً شرعيّاً؟! فلماذا لا يكون ما جرى على أهل البيت عليهم السلام من القتل - بأنواعه - أمراً شرعيّاً متعبّداً به، وقد تعبّدبه إبراهيم من قبل ؟! ولماذا لا يكون ما فعلوه تسليماً وتصديقاً لقضاء اللّٰه، وإحساناً؟! وقد تحمّلوه في سبيل اللّٰه، وأهداف الدين السامية!
وأمّا «البلاء» هُنا فهو «أبين»؛ لأنّه قد تحقّق، وأُريقت دماء آل بيت الرسول عليهم الصلاة والسلام، ولم يُفد عنهم بشيءٍ ! مع أنّ عمل الإمام، لم يكن امتحاناً خاصّاً وفرديّاً، بل هو عملٌ أعظم وأهمُّ ، لكونه إحياءً للإسلام ولرسالة اللّٰه الخالدة.
فإذا علم الإمام بتفصيل أسباب ما يجري عليه من الحوادث، ونتائجه الباهرة، فهو أحرى أن ينقاد لامتثال ذلك والإطاعة لإرادة اللّٰه، وعملٌ في مثل هذه العظمة والأهميّة، لا يكون الموت من أجله «تهلكةً ».
كلّ هذا مع عدم وجود «جبرٍ» ولا إكراهٍ للإمام على شيءٍ ، وإنّما الأُمور هي تحت اختياره، وبهذا يكون إقدامه أبلغ في الكشف عن عظمته وحبّه للّٰه والانقياد له تعالى، لمّا يختار لقاء اللّٰه تعالى على النصر الدنيوي. وقد جاء هذا المعنى الأخير في بعض روايات الباب.
فإذا لم يكن إقدامهم على ما أصابهم أمراً «مضرّاً» ولا يصحّ تسميته «تهلكةً »، ولا مانع من أن يكونوا عالمين به وعارفين له، فكيف يجعل إقدامهم عليه دليلاً على نفي علمهم به ؟!
ص: 93
هو الإمام الشيخ جمال الدين، الحسن بن يوسف بن المطهّر، أبو منصور، الشهير بالعلّامة الحلّي.
قال ابن داوود:
شيخ الطائفة، وعلّامة وقته، وصاحب التحقيق والتدقيق، كثير التصانيف، انتهت رئاسة الإماميّة إليه في المعقول والمنقول.
وقال ابن حجر:
ابن المطهّر عالم الشيعة وإمامهم ومصنّفهم، وكان آيةً في الذكاء... واشتهرت تصانيفه في حياته... وكان مشتهر الذكر حسن الأخلاق، ولمّا بلغه بعض كتاب ابن تيميّة قال: «لو كان يفهم ما أقول أجبتُه».
ومات في المحرّم سنة 726 ه عن 80 سنة(1).
وقد سأله السيّد المهنّا بن سنان بن عبد الوهّاب بن نميلة، من آل يحيى النسّابة ابن جعفر الحجّة بن عبيد اللّٰه الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين علي السجّاد عليه السلام فهو حسينيّ ، عُبيدليّ ، أعرجيّ ، مدنيّ .
قال ابن حجر(2):
الحسيني، الإمامي، المدني، قاضي المدينة، اشتغل كثيراً، وكان حسن الفهم، جيّد النظم، ولأُمراء المدينة فيه اعتقاد، وكانوا لا يقطعون أمراً دونه، وكان كثير النفقة، متحبّباً إلى المجاورين، ويحضر مواعيد الحديث... من فقهاء الإمامية، مع تحقّق المعرفة، وحسن المحاضرة، ومات سنة 754.
ووصفه العلّامة في أوّل جوابه عن مسائله بقوله:
السيّد الكبير، النقيب الحسيب النسيب، المعظّم المرتضى، عزّ السادة، زين
ص: 94
السيادة، معدن المجد والفخار، والحكم والآثار، الجامع للقسط الأوفى من فضائل الأخلاق، والفائز بالسهم المعلّى من طيب الأعراق، مزيّن ديوان القضاء، بإظهار الحقّ على المحجّة البيضاء عند ترافع الخصم، نجم الحقّ والملّة والدين.
وانظر الحقائق الراهنة في أعلام المئة الثامنة(1)، من طبقات أعلام الشيعة لشيخنا آقا بزرك الطهراني رحمه الله(2).
ذكر السيّد المهنّا بن سنان الحسيني المدني في المسائل الّتي وجّهها إلى العلّامة الحلّي، المسألة 15، منها سؤالاً هذا نصّه: ما يقول سيّدنا، فيما نُقل أنّ مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان يعرف الليلة الّتي يُقتل فيها ويُخبر بها؟! فكيف خرج عليه السلام في تلك الليلة، ملقياً بيده إلى التهلكة ؟! وإنّ فعله عليه السلام هو الحجّة.
لكن نطلب وجهاً نجيب عن الشبهة، فقد سأل المملوك عنها شخصٌ بدمشق.
فأوضح لنا ذلك، أحسن اللّٰه إليك.
ويبدو أنّ الشبهة كانت مثارةً من قبل آخر، ولعلّ الإثارة كانت من بعض المخالفين من أهل دمشق.
وفي هذا السؤال فائدةٌ جيّدةٌ ، حيث ورد فيه التنبيه إلى أنّ فعل الإمام لو كان حجّةً ، فلا معنى للاعتراض عليه، وذلك لأنّ من ثبتت إمامته وقامت الحجج على كونه إماماً مفترض الطاعة، فهو لا شكّ في كونه عالماً بأحكام اللّٰه تعالى، وكلّ ما يصدر منه هو طاعةٌ للّٰه، ولا تصدر منه المعصية؛ لأنّ الإمام عندنا يُشترط فيه العصمة عن الذنوب، وكذلك يُشترط فيه العلم بأحكام الشريعة بالإجماع.
فإذا ثبتت إمامته، لم يحاسب على شيء من إقدامه فعلاً أو تركاً، فكيف يتصوّر أن يكون ملقياً بنفسه إلى التهلكة، حتّى مع فرض علمه بما يجري عليه.
ص: 95
ففرض الإلقاء في التهلكة منافٍ لأصل ثبوت إمامته، فهو منتفٍ في حقّه، قبل أن يُبحث عن كونه عالماً بالغيب، وبما يجري عليه تفصيلاً... فلا يبتني نفي علمه بالغيب على فرض حرمة الإلقاء للنفس إلى التهلكة. وقد شرحنا هذا الأمر في صدر البحث.
وقد أجاب العلّامة الحلّي عن هذا السؤال بقوله:
يحتمل أن يكون عليه السلام أُخبر بوقوع القتل في تلك الليلة، ولم يعلم أنّه في أيّ وقتٍ من تلك الليلة! أو أنّه لم يعلم في أيّ مكان يُقتل!
أو أنّ تكليفه عليه السلام مغايرٌ لتكليفنا، فجاز أن يُكلّف ببذل مهجته الشريفة صلوات اللّٰه عليه في ذات اللّٰه تعالى، كما يجب على المجاهد الثبات، وإن أدّى ثباته إلى القتل، فلا يُعذل في ذلك(1).
والظاهر أنّ العلّامة إنّما أخذ في الاعتبار في جوابه فرض السائل أنّ إلقاء الشبهة ليس من قبل من يعتقد بالإمامة ومستلزماتها، بل من رجلٍ من المخالفين لا يعتقد إمامة الإمام، ولا يلتزم بشرائطها المعروفة من العصمة والعلم وغير ذلك.
وعلى ذلك، فلو أُريد إلزامه بعلم الإمام وتصديق الأخبار الدالّة على معرفته بمقتله، والّتي وردت ولم تُنكر، فلا بدّ من الخروج بأحد الوجوه الّتي ذكرها العلّامة، إمّا بالالتزام بتحديد الخبر الواصل إليه وأنّه عن أصل القتل وشخص القاتل دون زمانه المحدّد، أو بالالتزام بتحديد الخبر بما دون مكان معيّن. وعلى هذين الفرضين فلا ينافي إقدام الإمام حتّى على قتله؛ لأنّه لم يخبر بالزمان والمكان الخاصّين، حتّى يكلّف باجتنابهما، فلا يرد اعتراض أنّه أقدم على الهلكة.
وأمّا الجواب الثالث، فهو مناسب حتّى للسائل المعتقد بالإمامة، وهو أن يكون الإمام متعبّداً بتكليف خاصٍّ ، وهو مثل المجاهد المأمور والمكلّف بالجهاد حتّى
ص: 96
الشهادة. فالإمام كالمجاهد الّذي يُستشهد، لا يُعاتب ولا يُعذل؛ لأنّ فعله طاعةٌ ، وليس حراماً ولا معصيةً ، ولا يقال في حقّه: إنّه ألقىٰ بيده إلى التهلكة.
الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي بن المقصود علي الأصفهاني المجلسي (ت 1110 ه).
قال القمّي:
هو شيخ الإسلام والمسلمين، ومروّج المذهب والدين، الإمام، العلّامة، المحقّق المدقّق. كان إماماً في الجمعة والجماعة، وهو الّذي روّج الحديث ونشره، سيّما في بلاد العجم، وترجم لهم الأحاديث بأنواعها، مضافاً إلى تصلّبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع المعتدين والمخالفين من أهل الأهواء والبدع سيّما الصوفيّة والمبتدعين...(1).
وقد شرح اثنين من الكتب الأربعة - الأُصول الحديثيّة - بملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار، ومرآة العقول في شرح الكافي، وحاول جمع شتات كتب الحديث والأخبار في أكبر موسوعة حديثيّة وهي بحار الأنوار.
وقد بحث في المشكلة الّتي نبحث فيها في كتابه مرآة العقول الّذي شرح فيه أحاديث الكافي الّتي وردت في «باب أنّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون...»، ونقل فيه كلمات الشيخ المفيد في الرسالة العكبرية، والعلّامة الحلّي في جوابات المسائل المهنّائية، وممّا قال: منشأ الاعتراض أنّ حفظ النفس واجبٌ عقلاً وشرعاً، ولا يجوز إلقاؤها إلى التهلكة.
وقال في شرح جواب الإمام في بعض أحاديث الباب:
هو مبنيّ على منع كون حفظ النفس واجباً مطلقاً، ولعلّه كان من خصائصهم عدم
ص: 97
وجوب ذلك عند اختيارهم الموت. وحكم العقل في ذلك غير متّبعٍ ، مع أنّ حكم العقل بالوجوب في مثل ذلك غير مسلّمٍ (1).
وقد أجاب عن الاعتراض بوجوه ثلاثة:
وذلك لما ذكرنا سابقاً من أنّ هذا الواجب يسقط إذا زاحمه واجبٌ آخر أهمُّ متوقّفٌ على التضحية بالنفس، مثل حفظ الدين والإسلام، فلا بدّ من تقديم الأهمّ ، ويسقط غيره، فيجب التضحية بالنفس.
وقد احتمل المجلسي أن يكون عدم وجوب حفظ النفس خاصّاً بالأئمّة عليهم السلام عند اختيارهم الموت. وهذا الجواب مبنيّ على فرض ثبوت إمامته، وثبوت الاختيار له في انتخاب الموت، ومن الواضح أنّه مع هذا الفرض، لا يصحّ الاعتراض، كما أسلفناه في الأمر الثالث ممّا قدّمناه في صدر البحث، إذ أنّ فعل الإمام - حينئذٍ - حجّةٌ في نفسه، ودليلٌ على جواز إقدامه، من دون احتمال كونه إلقاءً محرّماً إلى التهلكة المنهيّ عنه.
إذ مع إقدام الإمام على فعلٍ ، وحسب المصلحة والهدف الصالح الأهمّ الّذي ارتآه، فلا أثر لحكم العقل واستهجانه؛ لأنّه إنّما يدرك المنافع العاجلة الظاهرية، لكنّ المتشرّع إنّما يصبو إلى النعيم الأُخروي والأهداف السامية، غير المرئيّة للعقل، ولا المطلوبة له.
لأنّ العقل إنّما يدرك الكلّيات، دون الأُمور الخاصّة، فلو فرضنا أنّ إلقاء النفس إلى
ص: 98
التهلكة كان أمراً قبيحاً عند العقل، فهو بمعناه الكلّي أمرٌ يدركه العقل العملي، وبصورته المجرّدة عن أيّة ملاحظة أو غرض يُتدارك به ذلك القبح. فلو ترتّبت على الإلقاء مصلحةٌ أوجبت حسنه، لم يكن للعقل أن يعارض ذلك، بل لا بدّ له أن يوازن بين ما يراه من القبح وما فيه من الحسن.
وبعبارةٍ أُخرى ليس ما يدركه العقل هُنا وفي صورة المعارضة للأغراض، واجب الإطاعة والاتّباع، وإنّما المتّبع هو الراجح من مصلحة الغرض أو مفسدة ما يراه العقل، كالعكس فيما يدرك العقل حسنه ولكنّ الأغراض تبعده والشهوات تأباه!
والحاصل: إنّ درك العقل للحسن والقبح الذاتيّين وإن كان مسلّماً، إلّاأنّ اتّباعه ليس واجباً، والعمل عليه ليس متعيّناً إذا أحرز الإنسان مصلحته في مخالفته، بعادةٍ أو عرفٍ أو شرعٍ .
وإذا علمنا بأنّ الأئمّة عليهم السلام إنّما أقدموا على القتل وتحمّل المصائب لأغراضٍ لهم - وهي الوجوه الّتي عرضنا بعضها وسنعرض بعضها الآخر - فلا أثر لحكم العقل في موردهم بقبح الفعل، ولا بوجوب حفظ النفس، بل قد يحكم بوجوب الإلقاء، وحرمة المحافظة على النفس، نظراً للأخطار العامّة والكبرى المترتّبة على حفظ النفس، ولفوات الآثار المهمّة بذلك.
وهذان الأمران - الثاني والثالث - إنّما طرحهما الشيخ المجلسي على أثر الإفراط في الاستناد إلى العقل وحكمه، إلى حدّ الاعتراض به على مسلّمات دينيّة وشرعيّة وتاريخيّة، اعتماداً على فرضيات واحتمالات نظريّة بحتة، لم يؤخذ فيها في النظر مسائل التوقيفات الشرعيّة ولا الآثار الواردة.
وهذا نظير ما اعتاد أن يلهج به صغار الطلبة من استخدام كلمة العقل ونقده، والفكر وصياغته وتجديده، والفلسفة والتبجّح بها، على حساب الدين والشرع والتاريخ، والعقيدة ومسلّماتها وأُصولها، والغريب أنّ ذلك يتمّ باسم الدين، وعلى يد من يتزيّى بزيّ أهل العلم والدين!
ص: 99
وقد ذكر الشيخ المجلسي في بحار الأنوار أجوبة الشيخ المفيد والعلّامة الحلّي بنصّها أيضاً(1).
المحدّث الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور الدرّازي البحراني.
قال أبو علي الحائري في منتهى المقال:
عالمٌ فاضلٌ ، متبحّرٌ ماهرٌ متتبّعٌ ، محدّثٌ ورعٌ ، عابدٌ صدوقٌ ، من أجلّة مشايخنا وأفاضل علمائنا المتبحّرين.
وقال الشيخ التستري في مقابس الأنوار:
العالم العامل، المحقّق الكامل، المحدّث الفقيه، المتكلّم الوجيه، خلاصة الأفاضل الكرام، وعمدة الأماثل العظام، الحاوي من الورع والتقوى أقصاهما، ومن الزهد والعبادة أسناهما، ومن الفضل والسعادة أعلاهما، ومن المكارم والمزايا أغلاهما، الزكيّ النقيّ التقيّ ...
وقال المولى شفيع في الروضة البهيّة:
من أجلّاء هذه الطائفة، كثير العلم، حسن التصانيف، نقي الكلام، بصير بالأخبار المرويّة عن الأئمّة المعصومين صلوات اللّٰه عليهم أجمعين... وكان ثقةً ورعاً عابداً زاهداً... من فحول العلماء الأجلّة.
وقال هو عن كتابه الدرر النجفيّة:
كتابٌ لم يُعمل مثله في فنّه، مشتملٌ على تحقيقات رائقةٍ ، وأبحاثٍ فائقةٍ .
وقال الحائري في منتهى المقال:
كتابٌ جيّدٌ جدّاً، مشتملٌ على علوم ومسائل، وفوائد ورسائل، جامعٌ لتحقيقات شريفة، وتدقيقاتٌ لطيفة(2).
ص: 100
فقد أورد في كتابه الدرر النجفيّة هذا الاعتراض، وأجاب عنه بالتفصيل، نورد ما يناسب ذكره هنا، قال:
درّة نجفيّة: كثر السؤال من جملة من الأخلّاء الأعلام، والأجلّاء الكرام عن الوجه في رضا الأئمّة عليهم الصلاة والسلام، وإعطائهم بأيديهم لما أوقعه بهم مخالفوهم من القتل بالسيف أو السمّ؟ حيث إنّهم عالمون بذلك، لما استفاضت به الأخبار من أنّ الإمام عليه السلام يعلم انقضاء أجله، وأنّه هل يموت بموت حتف أنفه، أو بالقتل أو بالسمّ ! وحينئذٍ، فقبوله ذلك وعدم تحرّزه من الامتناع، يستلزم الإلقاء باليد إلى التهلكة، مع أنّ الإلقاء باليد إلى التهلكة محرّم نصّاً، قرآناً، وسنّة!
وقد أكثر المسؤولون من الأجوبة في هذا الباب، بل ربّما أطنبوا فيه أيّ إطناب بوجوه لا يخلو أكثرها من الإيراد، ولا تنطبق على المقصود والمراد. وحيث إنّ بعض الإخوان العظام، والخُلّان الكرام سألني عن ذلك في هذه الأيّام، رأيت أن أكتب في المقام ما استفدته من أخبارهم عليهم الصلاة والسلام.
فأقول: - وباللّٰه الثقة لإدراك المأمول وبلوغ كلّ مسؤول -: يجب أن يُعلم:
أوّلاً: إنّ التحليل والتحريم توقيفيّةٌ من الشارع عزّ شأنه، فما وافق أمره ورضاه فهو حلالٌ ، وما خالفهما فهو حرامٌ . وليس للعقل - فضلاً عن الوهم - مسرح في ذلك المقام.
وثانياً: إنّ مجرّد الإلقاء باليد إلى التهلكة - على إطلاقه - غير محرّمٍ ، وإن أشعر ظاهر الآية بذلك، إلّاأنّه يجب تقييده وتخصيصه بما قام الدليل على جوازه، وذلك: فإنّ الجهاد متضمّن للإلقاء باليد إلى التهلكة، مع أنّه واجبٌ نصّاً وإجماعاً. وكذلك الدفاع عن النفس والأهل والمال.
ومثله - أيضاً - وجوب الإعطاء باليد إلى القصاص، وإقامة الحدّ عليه، متى استوجبه.
وثالثاً: إنّهم صلوات اللّٰه عليهم في جميع أحوالهم وما يتعلّق بمبدئهم ومآلهم
ص: 101
يجرون على ما اختارته لهم الأقدار السبحانيّة، ورضيته لهم الأقضية الربّانيّة.
فكلّ ما علموا أنّه مختارٌ له تعالى بالنسبة إليهم - وإن اشتمل على غاية الضرر والبؤس - ترشّفوه ولو ببذل المهج والنفوس.
إذا تقرّرت هذه المقدّمات الثلاث، فنقول: إنّ رضاهم صلوات اللّٰه عليهم بما ينزل بهم من القتل بالسيف والسمّ ، وكذا ما يقع بهم من الهوان والظلم على أيدي أعدائهم، مع كونهم عالمين به وقادرين على دفعه، إنّما هو لما علموه من كونه مرضيّاً له سبحانه وتعالى، ومختاراً له بالنسبة إليهم، وموجباً للقرب من حضرة قدسه والجلوس على بساط أُنسه.
وحينئذٍ، فلا يكون من قبيل الإلقاء باليد إلى التهلكة الّذي حرّمته الآية، إذ هو ما اقترن بالنهي من الشارع نهي تحريمٍ ، وهذا ممّا عُلم رضاه به واختياره له، فهو على النقيض من ذلك.
ألا ترى أنّه ربّما نزل بهم شيءٌ من تلك المحذورات قبل الوقت المعدّ والأجل المحدّد، فلا يصل إليهم منه شيءٌ من الضرر، ولا يتعقّبه المحذور والخطر؟! فربّما امتنعوا منه ظاهراً، وربّما احتجبوا منه باطناً، وربّما دعوا اللّٰه سبحانه في رفعه فيرفعه عنهم، وذلك لمّا علموا أنّه غير مرادٍ له سبحانه في حقّهم ولا مقدّر لهم.
وبالجملة: فإنّهم صلوات اللّٰه عليهم يدورون مدار ما علموه من الأقضية والأقدار، وما اختاره لهم القادر المختار.
ولا بأس بإيراد بعض الأخبار الواردة في هذا المضمار ليندفع بها الاستبعاد، ويثبت بها المطلوب والمراد:
* فمن ذلك: ما رواه ثقة الإسلام - عطّر اللّٰه مرقده - في الكافي بسنده عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للرضا عليه السلام: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله، والليلة الّتي يُقتل فيها، والموضع الّذي يُقتل فيه [إلى آخر الحديث الّذي نقلناه سابقاً](1).
ص: 102
وأضاف بعده: وحاصل سؤال السائل المذكور أنّه مع علمه عليه السلام بوقوع القتل، فلا يجوز له أن يعرّض نفسه له؛ لأنّه من قبيل الإلقاء باليد إلى التهلكة، الّذي حرّمه الشارع ؟!
فأجاب عليه السلام بما هذا تفصيله وبيانه: إنّه - وإن كان الأمر كما ذكرت من علمه عليه السلام بذلك - لكنّه ليس من قبيل الإلقاء باليد إلى التهلكة الّذي هو محرّم؛ لأنّه عليه السلام خُيّر في تلك الليلة بين لقاء اللّٰه تعالى على تلك الحال، أو البقاء في الدنيا، فاختار عليه السلام اللقاء على الوجه المذكور، لمّا علم أنّه مختارٌ ومرضيٌّ له عند ذي الجلال.
كما يدلّ عليه قوله عليه السلام لمّا ضربه اللعين ابن ملجم - المُلجّم بلجام جهنّم وعليه ما يستحقّه -: «فُزْتُ ورَبِّ الكعبةِ ».
وهذا معنى قوله: «لِتمْضِيَ مقاديرُ اللّٰهِ تعالى»، يعني: إنّه سبحانه قدّر وقضىٰ في الأزل أنّه عليه السلام لا يخرج من الدنيا إلّاعلى هذه الحال، باختياره ورضاه بها.
* ومن ذلك: ما رواه في الكتاب المذكور عن عبد الملك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام [وذكر الحديث الثامن الّذي رواه الكليني(1)].
* ومن ذلك: ما رواه - أيضاً - عن أبي جعفر عليه السلام في حديثٍ قال فيه:
فقال له حُمران: جُعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر قيام عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم، وقيامهم بدين اللّٰه عزّ وجلّ ، وما أُصيبوا من قتل الطواغيت إيّاهم، والظفر بهم حتّى قُتلوا وغُلبوا؟!
فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حُمران، إنّ اللّٰه تبارك وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم، وقضاه، وأمضاه، وحَتمه، على سبيل الاختيار، ثمّ أجراه. فبتقدّم علمه إليهم من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قام عليٌّ والحسن والحسين، وبعلمٍ صمت من صمت منّا.
ولو أنّهم - يا حُمران - حيث نزل بهم من أمر اللّٰه تعالى، وإظهار الطواغيت عليهم
ص: 103
سألوا اللّٰه تعالى أن يدفع عنهم ذلك، وألحّوا عليه في طلب إزالة تلك الطواغيت وذهاب ملكهم، إذاً لأجابهم، ودفع ذلك عنهم، ثمّ كان انقضاء مدّة الطواغيت وذهاب ملكهم، أسرع من سلكٍ منظومٍ انقطع فتبدّد.
وما كان ذلك الّذي أصابهم - يا حُمران - لذنبٍ اقترفوه، ولا لعقوبة معصيةٍ خالفوا اللّٰه فيها، ولكن لمنازل، وكرامةٍ من اللّٰه أراد أن يبلغوها! فلا تذهبنّ بك المذاهب فيهم(1).
أقول: وهو صريح في المطلوب، على الوجه المحبوب(2).
ثمّ روى عدّة أحاديث تدلّ على أنّهم عليهم السلام امتنعوا من فعل ما يؤدّي إلى قتلهم؛ لكون ذلك في غير الأجل المحدّد لموتهم، ولم يختاروا ذلك إلّافي الوقت المقدّر، حتّى يكون اختيارهم موافقاً للقضاء ورضاً به.
ويبدو من المقدّمة الأُولى والمقدّمة الثانية ممّا قدّمهما على الجواب، أنّه يوافق المجلسي رحمه الله في كليهما.
ولعلّ لجوءه إلى هذا الأُسلوب من جهة ميله إلى استبعاد تحكيم العقل في مثل هذه القضايا الّتي هي أُمور خاصّة، وليست كلّيات وثوابت عامّة حتّى يمكن للعقل التدخّل فيها، كما أنّ ما ثبت من الشرع فيه حكمٌ وجاء منه توقيفٌ ، فليس للعقل إلّا التسليم وترجيح المصلحة الشرعيّة على مدركاته.
وهذا - كما أشرنا سابقاً - نتيجةٌ كردّ فعل الّذي استحوذ على علمائنا الأخباريين على التطرّف الّذي انغمر فيه بعض العقلانيّين، ممّن قصُرت يده عن علوم الشريعة ونصوصها، فراح يجول ويصول في علوم الشريعة بجناح العقل وأدلّته، وبنى الدين أُصولاً وفروعاً وموضوعات خارجيّة وأُموراً واقعية، وأحداثاً تاريخيّة، على مدركاته العقليّة.
مع أنّ من الواضح أنّ الأُمور التعبّدية، وكذا الموضوعات الخارجيّة، وكلّ الأُمور والحوادث والحقائق الشخصيّة وصفات الأئمّة عليهم السلام وما صدر منهم... إلى غير ذلك
ص: 104
من الأُمور الخاصّة ليست مسرحاً للعقل، وإنّما طريقها الإثبات بالنقل.
والعقل النظريّ إنّما يدرك المعقولات العامّة الّتي ترتبط بالحقائق الكونية الثابتة، ولذلك يجب أن تكون مدركةً لجميع العقلاء ومقبولةً لديهم، لا خاصّة بعقل طائفةٍ دون أُخرى، ولا مبتنية على قضيّةٍ دون أُخرى.
أمّا العملي فهو يدرك حسن أمرٍ أو قبح آخر، ولا يستتبع عملاً، وإنّما للعالم أن يراعي مصلحته ويوازن فيه ما يخصّه بين ما يمسّه وبين ما يدركه العقل، فيرجّح ما يناسبه. فالانسحاب وراء الخيالات الخاصّة بعنوان العقل - كما يفعله أدعياء العقل ونقده في عصرنا الحاضر - جهلٌ بأبسط المسائل العقليّة، وهو مجال عمله.
هو المجتهد الكبير، والعلّامة النحرير، فريد دهره، ووحيد عصره، قدوة العلماء المتبحّرين، سيّد الفقهاء والمجتهدين، عمدة العلماء العاملين، ونخبة الأفاضل والمجتهدين، ملاذ الأنام، وثقة الإسلام، سيّدُنا الأعظم سماحة آية اللّٰه العظمى السيّد الميرزا محمّد الهادي الحسيني الخراساني الحائري، قدّس اللّٰه سرّه(1).
قال الشيخ محمّد حسن كُبّة، في إجازته له:
السيّد السند، والمولى الجليل المعتمد، فخر المحقّقين، وافتخار المدقّقين، صفوة العلماء الكرام، وعماد الفقهاء الأجلّة الفخام، التقيُّ النقيُّ ، الطاهر الزكيُّ ، نتيجة الشرف الأقدم، وسلالة سيّد الأُمم صلى الله عليه و آله و سلم.
وقال شيخ الشريعة الأصفهاني (ت 1339 ه) في إجازته له:
العالم العامل، الفاضل الكامل، أبو الفضائل والفواضل، صاحب القريحة القويمة، والسليقة المستقيمة، والحدس الصائب، والنظر الثاقب، المستعدُّ لإفاضة نتائج المطالب من الكريم الفيّاض الواهب، عمدة العلماء المحقّقين، وزبدة الفضلاء المدقّقين، العالم العلم العيلم، الثقة الورع، التقيُّ النقيُّ ، العدل الصفيُّ .
ص: 105
وقال السيّد مهدي الأصفهاني الكاظمي (من تلامذته):
كان رحمه الله من أعاظم علماء الفقه والأُصول، وأكابر فضلاء المقعول والمنقول، وكان عارفاً بالرجال، والتاريخ، والحديث، والتفسير، والعربية، ماهراً في الفنون العقليّة والنقلية.
وقال الكاظمي في أحسن الأثر(1):
وأمّا مناظراته: فإنّه إذا صادف خارج ملّة أو مذهب، فهو يفحمهم ويُلقمهم الحجر لا محالة؛ لما عليه من عظيم المقدرة في علم المناظرة، وزيادة إلمام بكلّ العلوم معقولها ومنقولها.
أمّا في المعقول: فإنّ له اليد الطولى في علم المنطق والحكمة والهيئة والرياضيات والكلام والفلسفة.
وأمّا في المنقول: فلقد برع فيه، واجتهد، وحاز السبق بها على معاصريه(2).
وفي عصر السيّد الخراساني في القرن الهجري الماضي (القرن الرابع عشر الهجري) خيّم شبح الاستعمار الغربيّ الملحد على البلاد الإسلامية، ودنّس الغربيّون أرض الشرق الطاهرة بأرجلهم الدنسة، وبدأوا بنفث سموم الفسق والإلحاد، وبذر الشقاق والفساد في كلّ قطرٍ وبين كلّ العباد، وحاولوا التفرقة بين أجزاء الوطن الإسلاميّ ، وقطع أوصال الأُمّة الإسلاميّة على أساس من الطائفيّة البشعة والعنصريّة المقيتة والنزاعات المفتعلة، ونصبوا بينهم العداء؛ ليأكل بعضهم بعضاً، فلا تكون لهم وحدةٌ متشكّلةٌ ، ولئلّا تكون أُمّةً قويّةً متراصّةً .
وحاولوا تأجيج شرر التفرقة بين المذاهب الإسلاميّة الفقهيّة، وتوسيع رقعة الخلاف بينها مهما أمكن، وتكبير الخلافات الصغيرة، وتأجيج النزاعات الحقيرة والقديمة، كما حاولوا تأسيس مذاهب فقهيّة جديدة، وإبراز فقهاء جدد ومجدّدين! وسعوا في إثارة النزاعات والخلافات بين أهل المذهب الواحد؛ لتّتسع رقعة الخلاف
ص: 106
على راقعها، ولقد جنوا على البشرية عامّة وعلى المسلمين خاصّة، بهذه الأعمال جنايةً كبرىٰ ، لكنّهم جنوا من أفعالهم تلك أنّهم استولوا على العباد والبلاد وخيراتها وتراثها وجمالها وحتّى عقولها، وذهبوا بكلّ ذلك إلى بلادهم في شمال العالم الأرضيّ لتعيش بها شعوبهم - قرناً من الزمان - في رفاهٍ من العيش ورغدٍ، وأمنٍ واستقرارٍ، وهدوءٍ وقانونٍ ، على حساب عذاب ملايين من أفراد البشر في سائر أقطار العالم الجنوبيّة.
وقد وجدوا في المذهب الشيعيّ الاثني عشريّ طائفةً متماسكةً مؤمنةً بمبادئ الإسلام الحقّة؛ لأنّها تعتمد على القرآن وأهل البيت، الثقلين اللذين خلّفهما الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بين أُمّته، ووعدها أن لا تضلّ ما تمسّكت بهما، وأنّهما لا يفترقان - أبداً - إلى يوم القيامة.
فكان الشيعة أقوى مذاهب الأُمّة يداً، وأكثرها صبراً وجلداً، وأوفاها للإسلام، وأشدّها دفاعاً عن القرآن، وأعلاها نداءً بالوحدة الإسلاميّة، وأكثرها سعياً للتقريب بين المسلمين. فلم يجد الاستعمار الغربي البغيض وأيديه العميلة إلّاالسعي في تشويه سمعة هذه الطائفة بين المسلمين من جهةٍ ، والسعي في تشتيت وحدة الشيعة من جهةٍ أُخرى.
وقد أثاروا الشُبه بين عوامّ الشيعة، والتشكيكات في المذاهب أُصولاً وفروعاً، ونبشوا التاريخ ليجدوا مثل هذه المشكلة «الاعتراض على علم الأئمّة بالغيب» فأثاروها، رغبةً في أن توجد شقاقاً في الطائفة الشيعيّة، بالرغم من كونها شبهةً بائدةً قديمةً ، وقد أجاب عنها علماء الشيعة منذ عُصُور الأئمّة وإلى اليوم بأجوبة سديدةٍ قويمةٍ .
إلّا أنّ الغربيّين الحمقىٰ وأذنابهم من السلفيّة والوهابيّة لا يهمّهم ذلك، وليس همّهم إلّاالتشبّث بكلّ ذريعةٍ ووسيلةٍ - ولو وهميّة - لإيقاع الفُرقة.
فانبرى السيّد الخراساني (ت 1948 م) للتصدّي لهذه الشبهة في رسالة «عروض
ص: 107
البلاء على الأولياء»، وقد ذكر فيها «عشرين وجهاً» من بنات أفكاره ومبدعات تحقيقاته، وكما قال: «من دون مراجعة أو إرجاع إلى مصدر أو كتاب». ونجد بعض الوجوه منها قد وردت في الأجوبة المذكورة فيما سبق من العصور، وخاصّةً في الأحاديث الشريفة.
ومن المطمأنّ به أنّ ذلك كان في مخزون فكر السيّد على أثر مراجعته الواسعة للمصادر، وخاصّة كتب الحديث الشريف. وقد يكون بعضها من توارد الأفكار؛ لأنّ تلك الوجوه كلّها، وخصوصاً ما ورد في الأثر منها، وجوه توافق الفطرة السليمة ويقف عليها صاحب السليقة المستقيمة، كما أنّه يوافق كثيراً من الحقائق الراهنة في حياة الأئمّة الأطهار عليهم السلام وسيرتهم الكريمة.
والسيّد الخراساني هو من عرفناه ابن هذه السلالة، وسائر على نهجهم، ومتعمّق بالغور في علومهم، وممتلئ مشبع بأفكارهم ومالك لأزمّة تراثهم، فلا غرو أن يكون ما توصّل إليه موافقاً لما ذكروه في النتيجة!
ورأينا من الأنسب أن نورد نصّ الرسالة هنا(1):
بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم
إنّما أذن اللّٰه تعالىٰ ، ورضي أولياؤه بعُروض البلايا ووقوع المظالم عليهم، وصبروا وسلّموا أنفسهم، حتّى تسلّط الأشرار والكفّار عليهم، ولم يسبّبوا الموانع والمدافع، حتّى أنّهم لم يسألوا اللّٰه تبارك وتعالىٰ كشف الكروب وهلاك الأعداء.
بل قال الخليلُ عليه السلام - بعد سُؤال جبرئيل -:
علْمُهُ بحالي يَكفي عن سؤالِي.
ص: 108
وأعظم من ذلك قول الحسين عليه السلام:
هَوّن ما نزل بي أنّه بعين اللّٰه.
كلّ ذلك لوُجوهٍ :
للفناء المحض، وكمال العبوديّة للّٰه تعالىٰ ، وعدم الاعتناء بما سواه، وأنّهُ (1) لايرى نفسه شيئاً، وذهل عن نفسه مع كمال قربه، فكيف يتوجّه إلى عدوّه مع كمال بعده ؟! فيعدّ الشكوىٰ والانضجار والدعاء عليه، توجّهاً إلى ما سوى الواحد الأحد المحبوب الصمد، وذلك انحطاطٌ لمرتبته الشامخة، بل مناقضةٌ لفنائه المحض.
لأنّ الرضا والتسليم لمشيئة اللّٰه تعالىٰ ، من أعلى مراتب العبادة، وذلك مُنافٍ للمعالجة في الدفع.
للعلم بعموم قدرته وكمال حكمته، وأنّه تعالىٰ لايعزُب عن علمه مثقال ذرّةٍ ، ولا يتصرّف أحدٌ في سُلطانه أقلّ من رأس إبرةٍ ، وأنّ الملك له لا شريك له، وأنّه لولا المصلحة التامّة لايوجد شيءٌ في العالم؛ لأنّه بشراشره(2) في حيطة تصرّفه، ومدارُه على وفق حكمته.
فكلّ ما يقع من الكائنات لابدّ وأن يكون بعلمٍ سابقٍ من اللّٰه وتقديرٍ أزليٍّ وقضاءٍ حتميٍّ ، وخيرُه أكثر من شرّه.
وإلّا لكانت الحكمة الإلهيّة، والقوّة الربّانيّة مانعةً عن وجوده. وهذا من غير أن يلزم جبرٌ في أفعال العباد، أو بطلان الثواب والعقاب(3).
ص: 109
إظهار عظمة اللّٰه تعالىٰ ، وصفاته الجماليّة والجلاليّة، وأنّه مستحقٌّ لكلّ ما يمكن من العبد من الفناء والتسليم(1).
ظهور علوّ مقام ذلك العبد، وسُموّ مرتبة تلك العبادة(2) حتّى يتأسّى به المتأسّون [كما قال اللّٰه تعالى:] «لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )(3) .
حتّى يهون الخطب والكرب على سائر الخلق في عالم الكون والفساد، فهذا لطفٌ من اللّٰه تعالى ومن أوليائه، بل أعظم نعمةٍ على العباد، ولذلك قد اجتمع للحسين عليه السلام من كلّ ما يتصوّر - من أنواع البليّات والمصيبات - أعظم الأفراد، حتّى يتسلّىٰ بملاحظته أرباب المصائب(4) ويتوجّه كلّ مكروبٍ إلى اللّٰه تعالىٰ ، ويبكي بتذكّر ما يُوافق كربه وشدّته من مصائب الحسين عليه السلام فيسأل اللّٰه كشف كربه، فيقضي حاجته ألبتّة، وقد جرّبنا ذلك.
وهذه غنيمةٌ أُهديت إليك، فاحتفظ بها بعون اللّٰه.
ص: 110
حتّى لايعترض سائر الخلق، ويسلّموا، وترضىٰ خواطرهم، إذا رأوا مقاماتهم العالية في الدنيا والآخرة.
[قال اللّٰه تعالىٰ :] «وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ عَسىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً»(1) .
حتّى يستحقّوا المثوبات العظيمة، والأُجور الثمينة، فإنّ الأجر على قدر المشقّة.
فلولا سجن يوسف عليه السلام وبكاؤُه وغربتُه ومخالفة هواه ومجانبتُه الحرام؛ لم يكن يستحقُّ تلك السلطنة العظمى مع النبوّة وعظيم الزلفة.
[قال اللّٰه تعالى:] «وَ كَذٰلِكَ مَكَّنّٰا لِيُوسُفَ فِي اَلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهٰا حَيْثُ يَشٰاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنٰا مَنْ نَشٰاءُ وَ لاٰ نُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِينَ * وَ لَأَجْرُ اَلْآخِرَةِ خَيْرٌ»(2) .
وهذا لا ينافي أن يكون اللّٰه تعالىٰ له أنٰ يُعطي جميع تلك المقامات لنبيّنا صلى الله عليه و آله و سلم أو للحسين عليه السلام وإن لم تعرض عليهما تلك البليّات من القتل والأذىٰ أصلاً؛ فإنّ ذلك يكون - حينئذٍ - «تَفَضُّلاً» لكون المحلّ لائقاً لكلّ جميلٌ ، والمبدأ لانقص في جُوده وفيضه، فكان له أن يعطيهم [- بلا ابتلاءٍ - عين] ما يُعطيهم مع الابتلاء، وإنّما الفرق بين الحالتين هو «التفضّل» و «الاستحقاق» ومعلومٌ أنّ في «الاستحقاق» مسرّةً وكمالاً لايوجد في غيره، من دون استلزام نقصٍ في المبدأ الفيّاض؛ لأنّ التسبيب إلى تكميل العبد، وتحصيل المسرّة والقرب بالعُبوديّة فيضٌ ، هو أفضل من التحفّظ على صرف «التفضّل».
مع ما في ذلك من المصالح السالفة والآتية، وغيرها ممّا لا يُحصىٰ .
وبما حقّقنا يُجاب عن:
ص: 111
الإشكال في «فائدة الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم»؟!
وأنّ فائدتها له عليه السلام أو للمُصلّي ؟!
وأنّه كيف يزيد على مقامات النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بصلاة أُمّته عليه ؟؟!!
فنقول: أثر الصلاة وطلب الرحمة من اللّٰه تعالى هو «الاستحقاق» وإن كان ما يعطيه اللّٰه تعالى بعد الصلاة، كان يعطيه ولو لم يصلّ أحدٌ عليه، ولكن كان العطاء من حيث «التفضّل»، أو: أثر الصلاة هو شدّة الاستحقاق، وإن كان أصله ثابتاً، ومعلوم أنّ الاستحقاق وتأكّد وجوده كمالٌ آخر، لا يكون مع «التفضّل».
إنّ التوجّه إلى اللّٰه تعالىٰ مع البلاء أكمل وأتمُّ من التوجّه مع الرخاء، ألا ترى أنّ الأنين والحنين مع حرقة القلب له أثرٌ عظيمٌ ، ربّما يؤثّر في الصخرة الصمّاء والنسمة البهماء.
وما خرج من القلب يدخل في القلب، وما يخرج من اللسان لم يتجاوز الآذان.
وفي الخبر:
اتّقوا دعوة المظلوم فإنّها تصعد إلى السماء كأنّها شرارةٌ .
وقال اللّٰه تعالى: «أَمَّنْ يُجِيبُ اَلْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ يَكْشِفُ اَلسُّوءَ »(1) .
وفي الشريعة المطهّرة ترتفع الحرمة والوُجوب لدى الاضطرار، فالمُضطرُّ موردٌ للترحُّم، والمظلُوم موردٌ للإعانة، لقُربه من اللّٰه. فكُلّما اشتدّ العبد بلاءً ازداد إلى اللّٰه قُرباً.
إنّ الفرج بعد الشدّة، والفرج بعد الكُربة، فيه لذّةٌ عظيمةٌ لاتوجد فيما سواه، فكلّما كانت مرارة الدنيا أقوىٰ ؛ كانت حلاوة العُقبىٰ أحلىٰ . وكذلك الشكر على ذلك يكون
ص: 112
بتوجّهٍ أكمل ورغبةٍ إلى اللّٰه أعظم.
ألا ترىٰ كلام أهل الجنّة: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا اَلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنٰا لَغَفُورٌ شَكُورٌ»(1) .
إنّ الضغطات العارضة على النفس، والاصطكاك الوارد على الروح، والصدمات الواقعة على الجسم، نظير الزناد القادح، فكما أنّه لا تخرج النار من الحجر إلّابشدّة ضرب الزناد، كذلك التنوُّرات القلبيّة والأشعّة الروحيّة لا تعقل فعليّتها إلّابتلك الآلام والمصائب.
أما سمعت قول سيّد الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم لسيّد الشهداء عليه السلام:
إنّ لك درجةً لن تنالها إلّابالشهادة.
فتلك الدرجة هي القوّة النوريّة المكنونة في ذاته المقدّسة، وفعليّتها كانت متوقّفةً على الشهادة.
إنّ تميُّز الخبيث من الطيّب، وبُلُوغ كلّ ممكنٍ إلى غايته، الّتي هي ذاتيّ المُمكنات المستنيرة من ساحة نور الأنوار، متوقّفٌ على هذه البليّات، فلولا صبر النبيّ وعترته الطاهرة صلوات اللّٰه عليه وعليهم؛ لما كان يصدر من الأعداء والمنافقين تلك القبائح والمظالم.
فإن قلت: وما الفائدة في فعليّة أولئك الظالمين، ذاتاً، وأفعالاً، وظهور أحوالهم الخبيثة ؟
قلت:
منها: تحرّز العباد من تلك الأخلاق والأفعال، فإنّه لمّا يلعنهم اللاعنون، ويتبرّأ
ص: 113
منهم العاقلون، يكون ذلك تحذيراً وتخويفاً لمن سواهم، وموعظةً بليغةً لمن عداهم.
ومنها: كمال معرفة مقام الأولياء، فإنّه «تُعرف الأشياء بأضدادها».
ومنها: تعذيبهم بأشدّ العذاب، ويكون الإخبار بذلك مانعاً للمؤمنين عن المعاصي في الدنيا، وسروراً لهم في الآخرة.
ومنها: ظهور الحجّة وبلوغها، وإثبات العذر للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وأمير المؤمنين عليه السلام في قتل الكفّار والمنافقين.
فإنّه لولا تحمّل الحسين عليه السلام وأصحابه في عرصة كربلاء وأسر عياله وسيرهم إلى الشام، لم يكن لأحدٍ العلم بأحوال رجال ذلك العصر. فلربّما يستشكل أحدٌ ويعترض، في تلك الحروب والقتال الواقع من النبيّ والوصيّ صلّى اللّٰه عليهما وآلهما!
فإنّهما عليهما السلام كانا مدافعين في جميع الوقائع لا مهاجمين، حتّى خروجه صلى الله عليه و آله و سلم إلى عيرأبي سفيان، فإنّه كان للد فاع عن المؤمنين المبتلين في مكّة، فوقعت حرب بدرٍ، بمجيء كفّار قريشٍ وهجومهم على المسلمين.
ولهذا كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يبتدئ بالقتال في [حربي] الجمل وصفّين، وكان ابتداء القتال من الأعداء، ولهذا قال عليه السلام لعمرو بن عبد ودٍّ:
أوّلاً: «أسألك أن تشهد الشهادتين»، فأبىٰ ذلك.
وثانياً: «ارجع بقريشٍ إلى مكة، وتنح عن القتال»، فأبىٰ .
وثالثاً: «إن لم تقبل إلّاالقتال، فانزل عن فرسك وقاتل».
وبالجملة: إنّما قتل النبيّ والوصيّ عليهما السلام مثل أولئك المنافقين الذين كانوا في كربلاء، وكلّهم كانوا يستحقّون القتل لنهاية خبثهم وظلمهم وفسادهم في الأرض، وسوء أخلاقهم، وقبح سرائرهم، وعظم جرائمهم، فكانوا لا يرجىٰ منهم الخير أصلاً، ولم يُعلم ذلك ولم ينكشف، إلّابعد وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في يوم كربلاء، حيث
ص: 114
كانت العترة الطاهرة يتحمّلون، ويصبرون كي ينكشف ذلك تمام الانكشاف.
وإنّما لم يفعلوا ذلك في حياته صلى الله عليه و آله و سلم؛ لعدم مقتضيه، ولتأييدٍ من اللّٰه والملائكة، ومع ذلك، فإنّ مظالمهم - للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وبني هاشم وسائر المسلمين في مكّة - قد بلغت الغاية!
ألم يحبسونهم ثلاث سنين في شعب أبي طالبٍ ، وقطعوا عنهم الميرة، فبلغ الجوع والضيق بهم ما بلغ ؟! ولولا مهاجرة المسلمين إلى الحبشة والمدينة، لقتلوهم أشدّ قتلةٍ ، سيّما بعد قتل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، إلّاإذا، كانوا يرتدّون إلى الكفر!
إنّ العبد إذا علم من نفسه أنّ البلاء ليس من جهة البعد من اللّٰه، بل إنّه من جهة قربه إليه تعالىٰ وحبّه له، بظهور كمال صبره ولياقته للمثوبات وعلوّ الدرجات، وعلم بما ذكرنا من الجهات؛ يستبشر بتلك البليّات، ويشكر اللّٰه عليها ويستأنس بها.
ألم تسمع عن شهداءالطفّ ، كيف كانوا يأنسون لوقع السيوف وإصابة السهام ؟ فكان عابس بن شبيبٍ قد نزع ثيابه وحمل عارياً، وكان سيّدهم الحسين عليه السلام كلّما اشتدّ عليه البلاء تهلّل وجهه وزاد نوره وقوي قلبه.
والعبّاس عليه السلام دخل الشريعة(1) وملأ القربة، ولم يذق الماء طلباً للقربة، فليس ذلك نقصاً في كماله، بل لو شرب لكان منافياً لجلاله.
ولهذا كانت تحف اللّٰه تعالى لعباده المقرّبين هي البلاء المبين، وكان البلاء للولاء، وإنّ من يحبّ اللّٰه تعالىٰ ينتظر بلاءه، وكلّما كان العبد أقرب إلى اللّٰه وأحبّ كان بلاؤه أعظم.
ولذا قال سيّد الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم:
ما أُوذي نبيٌّ مثل ما أُوذيتُ .
ص: 115
وأذيّة عترته عين أذيّته، فقد علم بها وكان يراها رأي العين، ويتحمّلها قبل وجودها، ولذا كان يبكي حين تذكّرها.
إنّ مصائب الأئمّة عليهم السلام - وبالخصوص الحسين عليه السلام - لها منافع عظيمةٌ لجميع المخلوقين، أعظمها غفران اللّٰه تعالى ورضوانه لمن بكىٰ عليهم، فقد صارت الجنّة واجبةً لمن دمعت عينه قطرةً في رزاياهم.
مضافاً إلى ما نرى من إقامة المآتم ومجامع التعازي، فينتفع بها العالمون منافع دنيويّةً وأخرويّةً ، ويؤيّد بها الدين، وتنشر العلوم والأحكام والمواعظ، وتقوّى العقائد ويجدّد الإسلام سنةً بعد سنةٍ ، ففي طول السنة تندرس أعلام الشرع، فإذا هلّ هلال محرّمٍ تجدّدت حياة الديانة، وهاجت روح الملّة، وبزغت شمس التديّن، وغرقت سفن أعداء الدين، وانهدم بنيانهم، واستؤصلت شأفتهم.
ولهذا نشاهد - والمشتكىٰ إلى اللّٰه - كمال جدّية الأجانب وتشديداتهم، في المنع من مجالس التعزية، ودفع المظاهر الدينيّة، وتشبّثهم بكلّ وسيلةٍ لسدّ هذا الباب، ودرس آثاره، ويساعدهم على ذلك جهّال المسلمين! ولا يتأمّلون ما فيه من اضمحلال آثار الإسلام، وانطماس أعلامه.
فهلمّوا يا إخواننا إلى هذه المأدبة الإلهيّة، والمائدة الربّانية(1) واغتنموا الفرصة، ولا تدعوا الأجانب يسلبوا ما به قوّتكم وسموّ شوكتكم، وإعزاز نصركم، ورسوخ إيمانكم.
ص: 116
إنّ بمظلوميّة الحسين عليه السلام بقيت الشريعة وحفظ الإسلام وحمي الدين، وسلم عن تغيير الفاسقين وتحريف المنافقين، وإلّا لكان يزيد وبنو أُميّة أعادوا الكفر والجاهليّة، وأبادوا الدين أُصولاً وفروعاً بالكلّية، إذاً كان يصفو لهم الملك، ويستقرّ عرش السلطنة.
ألم ترَ أنّه - لعنه اللّٰه - بمجرّد نيله الخلافة في أوّل أمره قتل الحسين عليه السلام وأباح المدينة وأحرق الكعبة مع تزلزل سلطانه ؟!
فكان الحسين عليه السلام بقبوله القتل قد أظهر ظلمهم وكفرهم، وصرف وجوه الناس وقلوبهم - عنهم - إلى دين جدّه. فكان إحياء الدين من جدّه صلى الله عليه و آله و سلم بغلبته، ومن الحسين عليه السلام بمغلوبيّته ومظلوميّته.
فلو كان عليه السلام يبقى في المدينة أو مكّة لكانوا يقتلونه غيلةً وإن كان يبايعهم! إلّاإذا كان يتابع رأيهم في تغيير الدين والردّة إلى الكفر، وحاشاه ثمّ حاشاه.
وكذلك صبر عليّ عليه السلام خمساً وعشرين سنة على أمرّ من العلقم، أبان للعالمين أنّ حروبه ومجاهداته وقتله الكافرين، لم يكن إلّابأمرٍ من اللّٰه تعالى، دون الهوى وطلب الدنيا والميل إلى سفك الدماء. وإلّا فلا يعقل - ممّن حاله ذلك - أن يضع يداً على يدٍ، ويحمل المسحاة على الكتف، فيصير حبيس بيته وراهب داره!
لكنّه عليه السلام رأى توقّف حفظ الإسلام، ورسوخه بين الأنام على جعل نفسه من أضعف الرعايا وأقلّ البرايا، وإلّا فهو لو سلّ ذا الفقار، لقالوا: كان قتاله في بدء الإسلام لمثل هذا اليوم! ولا ريب أنّ صبره هو الجهاد الأكبر؛ لأنّه جهاد النفس، وقد «فَضَّلَ اَللّٰهُ اَلْمُجٰاهِدِينَ عَلَى اَلْقٰاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً»(1) .
ص: 117
إنّ في شهادة الحسين عليه السلام ومصائب العترة وانصراف الخلافة عنهم وغصبها منهم، تصديقاً لرسالة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وتحقيقاً لنبوّته؛ لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يبعث أعزّ أهله وأبا نسله عليّاً عليه السلام إلى قتال أبطال القبائل وذؤبان العرب، فكان صلى الله عليه و آله و سلم يعلم ألبتة - ولو من غير طريق الوحي، بل بشاهد الحال من أحوال الرجال وسيرة هؤلاء العرب - أنّ عليّاً عليه السلام لا يقتل من عشيرةٍ أحداً إلّاوطلب كلّ واحدٍ من آحاد تلك العشيرة دم المقتول من القاتل، أو من عشيرته! فهم لا ينامون حتّى يأخذوا ثأرهم. فكان كلّ أحدٍ يعلم أنّ العرب لا يستقيمون لعليٍّ عليه السلام بعد تلك المقاتلات والثارات.
ولأجل ذلك كان الخلفاء الثلاث يحترزون عن المقاتلة في الحروب، فلم يسمع عن أحدٍ منهم أنّه حارب أو قتل أحداً، ولو من أراذل العرب وأذلّائهم! وقد أخبر صلى الله عليه و آله و سلم بأنّ حاصل تلك المقاتلات والمجاهدات هو القتل والأسر والظلم والجورعلى عترته من بعده.
ومع ذلك، فقد أقدم صلى الله عليه و آله و سلم على تأسيس الدين وقتال الكافرين بمباشرة أمير المؤمنين عليه السلام، فلو كان نظره صلى الله عليه و آله و سلم إلى الدنيا، لم يتحمّل هذه المشاقّ ولم يكن يدع أمير المؤمنين عليه السلام يقتل أحداً، فضلاً عن أن يبعثه على القتال مع جميع الأبطال.
فيقطع الناقد البصير بأنّه صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن له همٌّ سوى الآخرة، فبذل نفسه ونفيسه وتحمّل أعظم الرزايا وأشدّ الأذى في نشر الإسلام، كما قال صلى الله عليه و آله و سلم:
نحن أهل بيتٍ اختار اللّٰه لنا الآخرة على الدنيا.
إنّ في وقوعها(1) ظهور المعجزات القاهرة المصدّقة للنبوّة، حيث أخبر صلى الله عليه و آله و سلم عن
ص: 118
جميع ذلك، فوقع كلّ ما أخبر. وفيه الإعجاز من جهتين:
الأُولى: علمه صلى الله عليه و آله و سلم بها.
الثانية: صدقه في جميع ما أخبر، ووقوعه، حتّى أنّه لم يكن فيه بداءٌ ، فكان صدره الشريف كاللوح المحفوظ.
رضاهم وتسليمهم وتحمّلهم لها، دليلٌ قاطعٌ على إيمانهم وكمال عقائدهم وقوّة يقينهم باللّٰه تعالى وبوعده ووعيده. ولولاها فلعلّ أحداً يحتمل أو أمكن أن يقول:
إنّهم ظنّوا ولم يقطعوا، أو احتملوا فاحتاطوا(1)!
لكنّ رزاياهم موجبةٌ لليقين بأنّ الحاصل لهم هو أعلى مراتب حقّ اليقين، فيكون علمهم حجّةً على العالمين. وإنّ من لم يتيقّن فإنّما لضعفٍ في بصيرته، فيجب عليه متابعة هؤلاء المتيقّنين المتّقين.
ابتلاؤهم في الدنيا دليلٌ على المعاد ويوم الجزاء، وإلّا فيلزم أعظم وهنٍ في صنع العالم، لمخالفة الحكمة الواجبة، ونقض ما يشاهد ويحكم به الحدس الصائب من إتقان الصنع على أحسن نظامٍ وأكمل وضعٍ وأجمل ترصيفٍ .
فيجب - بحكم نظام العالم - أن لا يضيع أجر المحسنين، ولا يفوت جزاء الظالمين، وبما أنّ ذلك ليس حاصلاً في الدنيا، وجب - بالضرورة - أن يكون في الآخرة.
إنّ تحمّلهم للرزايا وشهاداتهم وقصر أعمارهم، لطفٌ لهم، وتقريب إلى الفوز
ص: 119
بنعيم المعاد، وتحصيل المراد، من جهة دلالة ذلك على عدم قابليّة هذه الحياة، ودناءة مرتبة الدنيا وعدم لياقتها، وأنّها قنطرةٌ إلى الآخرة، ولذا قالوا:
الدنيا ساعةٌ ، فاجعلها طاعةً .
فكأنّهم عليهم السلام برضاهم وتسليمهم بمنزلة من خيّره اللّٰه تعالى بين البقاء في الدنيا والرحيل، فاختار الرحيل، وأسرع عمداً، وعانق الموت رغبةً عن الدنيا، وشوقاً إلى الآخرة(1).
وبهذا(2) يجاب عن إشكال: إنّهم عليهم السلام إذا كانوا يعلمون بأوقات وفياتهم، وأسبابها، فلم لم يحترزوا عنها؟! وكيف باشروها وحضروها مع قوله تعالى: «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ »(3) ؟!(4).
وبذلك تعرف أنّ من فدىٰ روحه في «الحجّ » بدل الأُضحية شوقاً إلى لقاء اللّٰه، فهو في أعلى مراتب القرب والقبول. لكن لا يليق ذلك بكلّ أحدٍ، بل إنّما هو مشروطٌ بحصول اليقين الكامل والعشق الخارق، أمّا مع عدم التهيّؤ وكمال الاستعداد، ومع الشكّ والترديد، فهو من أعظم المآثم.
والحمد للّٰه ربّ العالمين.
الأوّل: إنّ المصنّف أراد تفصيل الإجابة عن إشكال الإلقاء في التهلكة، ولكنّه لم يكتبه،
ص: 120
بل ترك له فراغاً كما عرفت، وقد وفّقنا اللّٰه لذلك في هذه الدراسة.
الثاني: ممّا ذكر - في هذه الرسالة، وفي المقالة - ظهر ما في كلام السيّد الطباطبائي رضى الله عنه حول علم النبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام بالغيب، في رسالته المفردة عن الموضوع، حيث قال بعد تفريقه بين علم اللّٰه وبين علم الأئمّة، بالأصالة في الأوّل والاستقلالية به، والفرعيّة في الثاني والتبعيّة به، ما نصّه: «إنّ من المعلوم أنّ الإنسان الفعّال بالعلم والإرادة إنّما يقصد ما يتعلّق به علمه من الخير والنفع، ويهرب ممّا يتعلّق به علمه من الشرّ والضرر.
فللعلم أثر في دعوة الإنسان إلى العمل، وبعثه نحو الفعل والترك بالتوسّل بما ينفعه في جلب النفع أو دفع الضرر. وبذلك يظهر أنّ علم الإنسان بالخير، وكذا الشرّ والضرر في الحوادث المستقبلة إنّما يؤثّر أثره لو تعلّق بها العلم من جهة إمكانها لا من جهة ضرورتها.
وذلك كأن يعلم الإنسان أنّه لو حضر مكاناً في ساعة كذا من يوم كذا قُتل قطعاً، فيؤثّر العلم المفروض فيه ببعثه نحو دفع الضرر، فيختار ذلك الحضور في المكان المفروض تحرّزاً من القتل.
وأمّا إذا تعلّق العلم بالضرر - مثلاً - من جهة كونه ضروري الوقوع واجب التحقّق، كما إذا علم أنّه في مكان كذا في ساعة كذا من يوم كذا مقتول لا محالة، بحيث لا ينفع في دفع القتل عنه عمل، ولا تحول دونه حيلة، فإنّ مثل هذا العلم لا يؤثّر في الإنسان أمراً ببعثه إلى نوع من التحرّز والاتّقاء، لفرض علمه بأنّه لا ينفع فيه شيء من العمل، فهذا الإنسان مع علمه بالضرر والمستقبل يجري في العمل مجرى الجاهل بالضرر.
إذا علمت ذلك ثمّ راجعت الأخبار الناصّة على أنّ الّذي علّمهم اللّٰه تعالى من العلم بالحوادث لا بداء فيه ولا تخلّف، ظهر لك اندفاع ما ورد على القول بعلمهم بعامّة الحوادث من: «أنّه لو كان لهم علم بذلك لاحترزوا ممّا وقعوا فيه من الشرّ، كالشهادة قتلاً بالسيف، وبالسمّ ؛ لحرمة إلقاء النفس في التهلكة»!
ص: 121
وجه الاندفاع: إنّ علمهم بالحوادث علم بها من جهة ضرورتها، كما هو صريح نفي البداء عن علمهم. والعلم الّذي هذا شأنه لا أثر له في فعل الإنسان ببعثه إلى نوع من التحرّز، وإذا كان الخطر بحيث لا يقبل الدفع بوجهٍ من الوجوه، فالابتلاء به وقوع في التهلكة، لا إلقاء في التهلكة! قال تعالى: «قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ اَلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ اَلْقَتْلُ إِلىٰ مَضٰاجِعِهِمْ »(1) »(2).
أقول: وجوه النظر فيه عديدة، هي:
1 - عدم فرضه أنّ ما وقعوا فيه، ممّا عدّه الأغيار تهلكة وشرّاً وضرراً، إنّما هو في اعتبار الأئمّة عليهم السلام خير وبرّ ورحمة، كما هو عند الأخيار كافّة.
2 - فرضه أنّ ما جرى على الأئمّة من قبيل ضروري الوقوع، واجب التحقّق، وأنّه لا بداء فيه يقتضي الجبر؛ لعدم تمكّنهم من التخلّص منه، وهو منافٍ لصريح الروايات الدالّة على اختيارهم لما وقع، وأنّهم لو شاؤوا لم يقع.
3 - وفرضه أنّ العالم بالضرر يجري في العمل مجرى الجاهل، ينافي إثبات العلم لهم؛ فإنّه لو فُقد أثره لم يفرّق في ذلك في مقام العمل بينه وبين الجاهل، فمحاولة فرضه وإثباته لغو لا محالة.
4 - وفرضه أنّ علمهم لا بداء فيه، مخالف للنصوص الدالّة على أنّهم يختارون ذلك رغبةً في لقاء اللّٰه ورفضاً للحياة الدنيا، مع تخييرهم في ذلك.
5 - وفرضه أنّ ما جرى عليهم وقوع في التهلكة، ينافي إصرارهم عليهم السلام على ما أقدموا عليه ورفضهم لكلّ أنواع التحذيرات والتوسّل بهم لدفعهم على الامتناع، كما أعلنت عنها السيرة الشريفة لكلّ منهم.
6 - وأمّا استشهاده بالآية، فغير مرتبط بالمقام؛ لأنّها:
ص: 122
أوّلاً: في مقام تبكيت المنافقين الّذين قد أهمّتهم أنفسهم والّذين يظنّون باللّٰه غير الحقّ ظنّ الجاهلية. فأين هؤلاء من الّذين طلبوا الشهادة، واستيقنت بها أنفسهم، وأعلنوها «فوزاً» مقسمين «بربّ الكعبة»؟!
وثانياً: إنّ ما دلّ من الأخبار الصحيحة، والمشهورة، والسيرة الموثوقة، تخصّص الأئمّة عليهم السلام بكون موتهم باختيارهم كما عنون لذلك ثقة الإسلام الكليني في الباب الّذي عنونه ب «أنّ الأئمّة يعلمون متى يموتون، وأنّ ذلك باختيارهم».
الثالث: ما يرتبط بالنكتة الّتي ختم بها الرسالة، أقول:
ولذلك جعل اللّٰه لمن مات مهاجراً إلى اللّٰه ورسوله - في الحجّ - أجراً وقع على اللّٰه تعالى، هذا إذا مات بغير اختياره، فكيف إذا مات باختياره للموت ؟!
ويلاحظ أنّ الوجوه الّتي ذكرها السيّد الخراساني قد وضعت بشكل فنّي من حيث تفاعل المؤمن بالإسلام معها؛ لأنّها تعتمد على ربط الجوابات بالعقيدة:
* ففيها ما يرتبط بعقيدة التوحيد وصفات اللّٰه تعالى، وأنّه في منتهى العظمة واستحقاقها، وأنّه قادر حكيم، وأنّه قدّر الأُمور بحكمته، ومولويّته البالغة.
* وفيها ما يرتبط بالنبوّة وصدق النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وأنّ دعوة الإسلام صحيحة؛ لأنّ فداءها والواقفين في مقدّم صفوف المدافعين عنها هم أهل بيت النبيّ ، ولو كان ديناً مزيّفاً لوقف هؤلاء في المواقع الخلفيّة حتّى يستلذّوا من دنياهم وممّا زيّفوا، ولكنّهم أثبتوا بتضحياتهم أنّ الدين حقّ ، وأنّهم لم يجيؤوا به، ولم يحملوا رايته إلّاأداءً لواجب الرسالة والإمامة وحقّها. وهذا ممّا انفرد بذكره السيّد الخراساني.
وكذلك تصديق النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم الّذي أخبر متواتراً بما يجري فيما بعده على أهل بيته، فكان كما قال.
* وفيها ما يرتبط بالإمامة، وأنّ الأئمّة أثبتوا إخلاصهم للّٰه وللنبيّ ولهذا الدين وحقّانيّته، وأنّهم لم يطلبوا بالإمامة دنياً فانية، وإنّما هو الحقّ الّذي أرادوا تحقيقه، ولذلك ضحّوا بأنفسهم في سبيله.
ص: 123
* وفيها ما يرتبط بالعدل والمعاد، إذ إنّ المظالم الّتي جرت على أهل البيت الطاهر لا بدّ أن يكون لهم بها مقابل وأجر، والّذين قاموا بهذه المظالم ووطّدوا بها حكمهم في الخلافة والتذّوا بالحكم في دنياهم، لا بدّ أن يحاسبوا ويجازوا على ظلمهم، وقد ماتوا وهم مالكوا أرائكها، أين يجدون جزاء ما جنوا بعد هذه الدنيا؟! إنّ العدل والوجدان، يقتضيان أن تقام محكمة تأخذ الحقّ وتحاكم العدوان وتنزل القصاص، وتوصل المجرمين إلى الهوان، وتعطي المظلومين حقوقهم.
وقد ملئت رسالة السيّد الخراساني بالمعاني الدقيقة والفوائد الجليلة والإفادات الروحية والعرفانيّة الرفيعة، ممّا يزيد من روعتها وعظمتها العلميّة والروحيّة.
في مطلع القرن الخامس عشر الهجري، وفي العقد الأخير من القرن العشرين، حين هبّت رياح النصر الإلٰهي للأُمّة الإسلامية من خلال حركة دينية قادها الزعيم العظيم من سادة أهل البيت، السيّد الورع التقيّ المجتهد المجاهد، الإمام روح اللّٰه الخمينيّ ، فجدّد للإسلام رسمه واسمه وقوّته، وأعاد إلى المسلمين ثقتهم بأنفسهم، وصدّقوا بقدرتهم، ووجدوا ذاتهم العظيمة بعد تياهٍ ويأسٍ وبؤسٍ وشقاءٍ فرضتها عليهم إيحاءات الغربيّين بالتخلّف والضعف والعجز، والاستخفاف بالشرق وأديانه وأعرافه وأذواقه وتراثه!
فنفخ الإمام الخمينيّ في الأُمّة روح القوّة والوحدة والأُلفة والمجد والعزّة، وأيّده اللّٰه تعالى بجنودٍ لم يرها المستعمرون الملحدون، من شباب الأُمّة ومستضعفيها، وممّن لم يحسب لهم الطواغيت حساباً، فانتصروا بأيدٍ خاليةٍ من السلاح - سوى سلاح الإيمان - على أكبر دول المنطقة عمالةً وغطرسةً ، وأوسعها مساحةً وإمكانياتٍ ، وهي دولة «إيران» الشاه العميل، والمرتمي في أحضان أمريكا، والّذي جعل من بلده ترسانةً لأنواع الأسلحة الاستراتيجية.
ص: 124
كان هذا الانتصار العظيم بعد قرنٍ من سيطرة الغرب الكافر على أرض الإسلام، من حدوده الشرقيّة إلى سواحله الغربيّة وبعد عملٍ دقيقٍ ودؤوبٍ وماكرٍ بالاستيلاء على كلّ مرافق الحياة الحسّاسة، وقد سلّط عليها - من بعد - عملاءه.
لكنّ الأُمّة الإسلاميّة أصبحت من الرشد والوعي وبفضل أجهزة الإعلام الحديثة، بحيث لا يخفىٰ عليها ما يجري في أنحاء العالم كلّه، وفي العالم الإسلاميّ بالذات، فلا يخفى عليها دجل الدعايات الكاذبة الّتي تروّجها الوهّابيّة المنبوذة والسلفيّة الممقوتة والعلمانيّة الملحدة، وكلّ الّذين وضعوا أيديهم أمس - أو يضعونها اليوم، أو غداً - في أيدي الصهيونيّة الحاقدة على الإسلام والمسلمين!
إنّ الصحوة الإسلاميّة المجيدة والعودة الحميدة إلى الإسلام الّتي عمّت البلاد الإسلاميّة من الشرق إلى الغرب، إنّما هي ثمرةٌ يانعةٌ من ثمار حركة الإمام الخمينيّ المقدّسة، وإنّ الوعي الإسلاميّ العظيم لن تنطلي عليه أساليب الاستعمار وذيوله الماكرة، والّتي بليت وتهرّأت في سبيل تشتيت كلمة المسلمين وتفتيت قواهم، وإثارة الفتن والقلاقل - بالكذب والبهتان والتكفير - فيما بينهم.
لقد استخدموا هذه المرّة - وفي هذه الأيّام بالذات - عناصر من داخل الإطار الشيعيّ ، ببعث بعض المنبوذين من المنتمين بالاسم أو المواطنة أو الأُسرة، إلى الإسلام، ودفعهم إلى الكتابة باسم الشيعة ضدّ الثورة الإسلاميّة. ومن ذلك ما صدرأخيراً من إثاراتٍ تشكيكيّةٍ ضدّ عقائد المذهب وتراثه ومصادره وتاريخه.
عادوا إلى بثّ بذور النفاق والشقاق بين الطائفة الشيعيّة - العمود الفقري للحركة الإسلاميّة الجديدة - ليقصموا بذلك ظهرها، ويخنقوها في مهدها! وذلك بإثارة الشبه والدعايات المغرضة.
وممّا أثاروه تلك الشبهة البائدة القديمة، وقد تولّى كبرها وإثارتها من يدّعي العقل ونقده سارقاً لمجموعة من النصوص من هذا الكتاب وذاك، ومراوغاً في الكلمات والجمل والفصول، زاعماً أنّه اهتدىٰ إلى هذه المشكلة وحلّها، وأنّه يقوم بقراءةٍ
ص: 125
جديدةٍ للفكر الإسلاميّ والعقل الشيعيّ ! أو يصوغهما صياغةً جديدةً !
إنّ الشبهة هذه قد أكل الدهر عليها وشرب، وقد أرهقها علماؤنا منذ القدم وفي مختلف العصور ردّاً وتفنيداً! فلم يكن في إثارتها في هذه الظروف، إلّالغرضٍ سياسيٍّ مشؤومٍ ولزلزلة التزام المؤمنين العقيديّ ، وفصل عرى الوحدة الإيمانيّة بينهم.
ولقد وفّقني اللّٰه - حمايةً للعقيدة، ودفاعاً عن الفكر الإسلاميّ ، وانتصاراً لحركة الإسلام الجديدة، وتزييفاً لمثل تلك المحاولات اللئيمة، وتحصيناً لمعتقدات المؤمنين - أن أقوم بهذا الجهد المتمثّل في البحث عن أُصول المشكلة، وتحديد محلّ البحث منها، وعرض الأجوبة الموروثة منذ عصر الأئمّة عليهم السلام وحتّى اليوم.
والهدف - بعد نسف تلك الدعوى الّتي أثارتها أجهزة الكفر، وإبطال ما توهّموه حلّاً لها، والّذي هو الهدف من إثارتها، وهو نفي علم الأئمّة بالغيب! - هو إشباع المسألة بحثاً وتنقيباً حتّى يقف المسلم على حقيقة الأمر وجليّته بكلّ أبعاده.
وقد توصّلنا من خلال ذلك إلى نتائج مهمّةٍ ، نلخّصها فيما يأتي من صفحات:
1 - يعتقد الشيعة الإماميّة بأنّ علم الغيب، بالاستقلال خاصٌّ باللّٰه تعالى، بنصّ القرآن الكريم.
2 - ويعتقدون أنّ اللّٰه تعالى يُطلع النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على الغيب بوسيلة الوحي أو الإلهام، وهذا أيضاً منصوصٌ عليه في القرآن الكريم، ومذكورٌ في الحديث الشريف. وكذا الإمام يعلم ذلك بواسطة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.
3 - أجمعت الطائفة الإماميّة على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والإمام يعلمان - بإعلام اللّٰه وإطلاعه - الغيب، سواءٌ في الأحكام أو في الموضوعات، ويدخل في ذلك علمهم بأسباب موتهم والمصائب الجارية عليهم، وما يرتبط بذلك من الزمان والمكان
ص: 126
والفاعل، علماً تفصيليّاً.
إلّا أنّ أفراداً خالفوا في خصوص «وقت القتل»، فاعتقدوا فيه بالعلم الإجمالي، وعدم التحديد التفصيليّ ؛ حذراً من ورود الاعتراض التالي عليهم، ويترتّب على القول بالتفصيل كونهم عليهم السلام مختارين في انتخاب الموت لأنفسهم. وقد دلّت على ذلك الأحاديث والآثار المنقولة.
4 - لقد اعترض المنحرفون والخارجون عن المذهب على الشيعة في أصل «علم الأئمّة بالغيب»، واستدلّوا على ذلك بالآيات، وبدليل العقل بمحدوديّة المخلوقين، فلا يمكنهم الإحاطة بالغيب الّذي هو غير محدودٍ.
ورُدّ هذا الاعتراض: بأنّ اللّٰه تعالى نصّ في القرآن بأنّه يُطلع من يشاء من الرسل على الغيب.
وأمّا العقل، فبأنّ ما ذكر من اللّازم، إنّما يلزم على تقدير ادّعاء أنّ غير اللّٰه يعلم الغيب بالاستقلال وبنفسه، وقد عرفت أنّ ذلك خاصٌّ باللّٰه تعالى، ولا يشركه فيه أحدٌ من المخلوقات بشراً أو ملائكةً أو غيرهما. وإنّما نقول في مسألة علم النبيّ - ويتبعه الإمام بما يُطلعهما اللّٰه تبارك وتعالى عليه من مخزون علمه، وبإرادته.
وقد استأثر اللّٰه لنفسه بكثيرٍ من العلوم، كعلم الساعة ووقتها، وأمر الروح، ولكنّه بفضله على أوليائه من الرسول والأئمّة عليهم السلام يُلهمهم علوماً اختصّهم بذلك دون البشر؛ كرامةً لهم وإعظاماً لشأنهم.
وقد استثنى اللّٰه تعالى ذلك ممّا دلّ على حصر الغيب بنفسه، في القرآن الكريم.
فليس اعتقاد ذلك منافياً لمدلول تلك الآيات الّتي هي حقّ .
5 - ومع اعتقادنا بأنّ النبيّ والإمام يعلمان الغيب بإعلام اللّٰه، ويطّلعان عليه بالوحي والإلهام، فإنّ علمهما لا بدّ أن يكون محدّداً بحدود الوحي والإلهام والإعلام الإلهيّ وإطلاعه جلّ وعزّ لهما على ما يشاء من الغيب. وقد دلّت الأحاديث والآثار والنقول - المتواترة بالمعنى - على حصول علم الغيب لهم عليهم السلام في بعض القضايا والأُمور
ص: 127
الماضية والمستقبلة.
وهذا في نفسه كافٍ لإبطال ما أُقيم من الشبه - في وجه هذا المعتقد - باسم الأدلّة العقليّة، فلو تحقّق علمهم بالغيب بنحو الموجبة الجزئيّة؛ انتقض الدليل على سلب ذلك كلّياً، ونفيه بصورة عامّة.
لكنّ ذلك لا يستلزم الإثبات الكلّي، إلّاإذا دلّ الدليل عليه، كما وردت به الروايات والآثار العديدة، وحيث لا مانع - شرعياً ولا عقليّاً - من الالتزام بها بعد كونها ممكنةً ، فلا نرى في الالتزام بمداليلها ومضامينها محذوراً.
6 - وقد أُثيرت في وجه الالتزام بهذه الروايات والآثار والاعتقاد بعلم الغيب للنبيّ والأئمّة عليهم السلام «شبه»، من قبيل الحوادث التاريخيّة المنقولة في سيرتهم عليهم السلام والّتي تتضمّن قضايا ظاهرها عدم علم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام بالنتائج المترتّبة عليها.
مثل ما في قضيّة خالد بن الوليد وفعلته المنكرة في إحدى قبائل العرب، الّتي قتل فيها جماعة من المسلمين، ولمّا اطّلع الرسول على فعله تبرّأ منه وبعث من فداهم.
فلو كان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم علم ما سيفعله خالدٌ لما أرسله، ولمنعه ولأبدله بغيره ؟! وكذلك تأمير الإمام عليّ عليه السلام زياد ابن أبيه، الّذي أدّى بعد ميله إلى معاوية إلى فتكه بالشيعة، فلو كان الإمام يعلم عاقبة أمره لما ولّاه ولما اعتمد عليه ؟!
وقضايا أُخرى ظاهرها أنّ النبيّ والإمام كانا يظهران أسفهما على ما صدر منهما، ممّا يدلّ على عدم علمهما بالنتائج!
أقول: إنّ هذه القضايا التاريخيّة لا يمكن الاعتماد عليها في بحث علم الغيب؛ لكونها قضايا مبتورة لم تنقل بتفاصيلها الواضحة، بل لا يعتمد على ناقليها الّذين ليسوا إلّامن كتّاب الأجهزة الحكومية ومؤرّخي السلطات، والّذين يسعون إلى إخفاء حقائق كثيرة من كلّ ما يروونه، فلم نعرف عنها تفصيلاً لكلّ جزئيّاتها وخصوصياتها، ومع ذلك لا يمكن الحكم من خلالها على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ولا الإمام عليه السلام بشيء ما لم نعرف كلّ ظروفها ومجرياتها.
ص: 128
ثمّ إنّ النبيّ والإمام عليهما السلام لم يكن بإمكانهما إبداء كلّ ما يعلمان والتصريح بكلّ شيء إلى من حولهما من الناس؛ لاختلاف مقاماتهم في العقيدة والإيمان والالتزام والتصديق وقابلية الإدراك والتعقّل وسعة المعرفة وبعد النظر والتقوى والزهد في الشهوات، ولذلك تجد اختلافاً في الخطابات الصادرة إليهم حسب مستوياتهم، فليس بإمكان النبيّ والإمام التصريح بكلّ الحقائق لكلّ السامعين، وليس من المفروض أن يقبل جميع السامعين ما يسمعون، وكذلك ليس كلّ الناقلين أُمناء فيما ينقلون.
ومع هذه الحقائق لم يبق اعتماد على مثل هذه القضايا المبتورة بحيث تُردّ به الأخبار والآثار المتظافرة الواردة عن علم الأئمّة عليهم السلام بالغيب، وإن صحّت، فالنبيّ والإمام عليهما السلام مكلّفون أن يتصرّفوا ويتعاملوا مع الآخرين حسب ظواهر الأُمور والأسباب الطبيعيّة، لا على أساس ما يعلمونه من الغيب.
إنّ من الغريب أن يحاول المغرضون مواجهة ما ورد من روايات علم الغيب بالإشكالات السنديّة، ومعارضتها بمثل هذه القضايا الّتي لم تثبت حتّى بسندٍ ضعيفٍ ، وإنّما هي أخبارٌ تاريخيّةٌ لا يُعتمد على ناقليها في مجال القصص، فضلاً عن مجال الأحكام والعقائد!
7 - وقد اعترضوا على علم الأئمّة عليهم السلام بالغيب أنّه يستلزم أن يكونوا قد أقدموا على إلقاء أنفسهم إلى التهلكة؛ لأنّ خروجهم إلى موارد الخطر - مع علمهم بذلك - يلزم منه ما ذكر.
والإلقاء إلى التهلكة حرامٌ شرعاً بنصّ القرآن الكريم، وحرامٌ عقلاً؛ لأنّه إضرارٌ بالنفس، وهو قبيحٌ . مع أنّه لا ريب في قُبح ما أجراه الظالم على أهل البيت عليهم السلام بل هو من أقبح القبيح، فكيف يُقدم الأئمّة العالمون بقبحه عليه ؟!
وقد أُجيب عن ذلك بوجوه:
الجواب الأوّل: إنّ هذا الاعتراض إنّما يتصوّر ويُفرض بعد الاعتقاد بعلم الأئمّة
ص: 129
للغيب، أمّا لو أُنكر ذلك ولم يعتقد بعلمهم به، فلا يرد الاعتراض؛ لأنّه مع عدم العلم لا يكون الإقدام إلّاعلى ما يجوز، وليس إلقاءً إلى التهلكة، فلا يكون الاجتناب عليه واجباً؛ لعدم التكليف بما لا يعلم، ورفعه عمّن لا يعلم، فلا يكون الاعتراض وارداً.
ومع ذلك يُعلم أنّ الجمع بين الاعتراضين في الأسئلة الّتي وردت في هذا المجال وكذا الكتب الباحثة عنه، إنّما هو مبنيّ على الجهل والغرض الباطل.
وكذلك نعلم أنّ الأسئلة إنّما يوجّهها غير الشيعة ويعترضون بها على الشيعة بفرض اعتقادهم في الأئمّة بعلم الغيب، وأنّه على هذا التقدير يأتي الاعتراض بالإلقاء إلى التهلكة. ولكن إذا ثبت أو فُرض علم الأئمّة بالغيب، فالجواب عن الاعتراض بما سيأتي من الوجوه الأُخر.
الجواب الثاني: إنّ الأئمّة إذا ثبتت إمامتهم بالأدلّة القطعيّة الواردة في كتب الإمامة، فلا بدّ أن تتوفّر فيهم شروطها الّتي منها «العصمة» و «العلم بالأحكام الشرعيّة»؛ لاقتضاء مقام خلافة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ذلك.
وحينئذٍ، فالمعتقد بالإمامة يسلّم بأنّ الإمام لا يُقدم على فعل الحرام، فلا يكون إقدامهم على ذلك من الإلقاء المحرّم، ولا بدّ من الالتزام بأحد التوجيهات الآتية، وأمّا غير المعتقد بالإمامة فلا يرى لزوماً لأصل الاعتقاد بعلم الأئمّة، فلا وجه في اعتراضه؛ لأنّه لا يراهم مقدمين على ما يعلمون! فهذا الاعتراض على كلا الفرضين غير وارد.
الجواب الثالث: إنّ درك العقل لقبح صدور ذلك من الظالمين لا يُنكر، لكنّه لا يستلزم قبحاً على المظلومين؛ لعدم رضاهم بذلك وعدم تمكينهم، وإنّما قاموا بما يلزمهم القيام به حسب وظائفهم وما يراد منهم، وهو حكم عليهم من قبل اللّٰه تعالى، فلا يكون إقدامهم على الأُمور الحسنة أو المباحة قبيحاً بإرادة الظالم وفعله، وكلّ من الظالم والمظلوم مكلّف ومحاسب على ما يقوم به حسب وظيفته ونيّته، فالأعمال بالنيّات، ولكلّ امرئٍ ما نوىٰ .
ص: 130
الجواب الرابع: إنّ شمول «الإلقاء المحرّم» لإقدام الأئمّة عليهم السلام غير صحيح، لا شرعاً ولا عقلاً.
أمّا شرعاً، فإنّ الإلقاء إنّما يكون حراماً إذا كان إلى التهلكة، وليس الموت في سبيل اللّٰه تهلكة، وإنّما هو عين الفوز والنجاة والسعادة والحياة في نظر الأئمّة عليهم السلام وشيعتهم، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام - لمّا ضُرب بالسيف على رأسه -: «فزتُ وربّ الكعبة»، وكما قال الحسين عليه السلام: «إنّي لا أرى الموت إلّاسعادةً ، والحياة مع الظالمين إلّابرماً».
وأمّا عقلاً: فلِما مرّ من أنّ الحكم بحرمة الإلقاء إلى التهلكة ليس مطلقاً، بل إنّما هو - على فرض وروده - خالياً عن مصلحة وأدرك العقل قبحه، ولا يكون حراماً إذا كان فيه نفعٌ أهمّ وأعمّ ، وكان في صالح الإنسان المقدم عليه نفسه، أو في صالح أُمّته أو دينه أو وطنه؛ لأنّ العقل حينئذٍ يقدّم مصلحة الفعل على مفسدة القبح المدرك، فلا يحكم بحرمته ولا يعاقب المقدم عليه، بل يُثاب.
وعلى فرض وروده، وإطلاق حكمه، فهو ليس إلزاميّاً إذا عارضته أحكام دينيّة وأغراض شرعيّة ومصالح عامّة إلهيّة، وإنّما هو مجرّد إدراك وجداني يصادمه إدراك ضرورة وجدانيّة باتّباع الأحكام الدينيّة والإرادة الإلهيّة.
وأمّا المصالح الّتي ذكروها في الإقدام على الأخطار وعروضها على الأئمّة الأطهار، فهي الوجوه التالية:
الأوّل: العمل بمقتضى القضاء الإلهيّ والقدر الربّاني والانصياع للإرادة المولوية، الّتي يعلمها الأئمّة عليهم السلام. وقد ورد هذا الوجه في حديث للإمام الباقر عليه السلام وللإمام الرضا عليه السلام، وذكره عدّة من العلماء الأبرار.
الثاني: اختيار لقاء اللّٰه تعالى على البقاء في الدنيا الفانية. وقد ورد في الحديث الشريف أيضاً.
الثالث: التعبّد بأوامر اللّٰه تعالى بأن يقدّموا أنفسهم قرابين في سبيل الدين، ويضحّوا بأرواحهم الطاهرة من أجل إعلاء كلمة الدين. ذكره الشيخ المفيد، ونسبه
ص: 131
الشيخ الطوسي إلى جمهور الطائفة، وذكره جمعٌ من بعده كالعلّامة الحلّي وغيره.
الرابع: إنّ ما ترتّب على ذلك من المصالح الدنيويّة والمقامات الدائمة الأُخرويّة، يتدارك بها ما فيها من الآلام الزائلة.
وهناك وجوهٌ أُخر ومصالح دقيقة عرفانيّة مستنبطةٌ من سائر أحوالهم وأقوالهم، جمعها سماحة آية اللّٰه العظمى الإمام الخراساني في كتابه عروض البلاء على الأولياء ذكرناها مجملاً، ولا نطيل هذا الملخّص بإعادتها.
وقد وفّقني اللّٰه تبارك وتعالى، لإعداد هذا البحث في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الإسلام والمذهب، حيث يستهدف الكفر العالميّ الحضارة الإسلاميّة بأعنف الحملات الطائشة.
وكان دوري - بعد التجميع لنصوص الإجابات المعروضة في طول التاريخ - أنّي وضعتها في إطار قراءات تحليليّة يمكن من خلالها الوقوف على الأبعاد الدلاليّة والعقيديّة غير المنظورة.
وأسأل اللّٰه أن يتقبّل هذه الخدمة للحقّ ، وأن يُثيبنا في الدنيا بالتوفيق للعلم والعمل الصالح، وفي الآخرة بالمغفرة والجنّة، وأن يُلحقنا بالصالحين.
والحمد للّٰه ربّ العالمين.
ص: 132
1. أجوبة المسائل المهنّائية، الحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف بالعلّامة الحلّي (ت 726 ه)، قمّ : مطبعة الخيّام، 1401 ه.
2. أوائل المقالات في المذاهب المختارات، محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد (ت 413 ه)، قمّ : طبعة مؤتمر الشيخ المفيد، 1413 ه، وطبعة مكتبة الداوري.
3. بحار الأنوار، محمّد بن باقر بن محمّد تقي الأصفهاني المعروف بالعلّامة المجلسي (ت 1110 ه)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1403 ه، الجزء 42.
4. تفسير الحِبَريّ ، الحسين بن الحكم بن مسلم الحِبَريّ الكوفي (ت 281 ه)، تحقيق: السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي، بيورت، 1408 ه.
5. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف بن أحمد آل عصفور البحراني الدرّازي (ت 1186 ه)، النجف الأشرف: دار الكتب الإسلامية، 1376 ه.
6. الحسين عليه السلام سماته وسيرته، محمّد الحسيني الجلالي - طبع.
7. الدرر النجفيّة، يوسف بن أحمد آل عصفور البحراني الدرّازي (ت 1186 ه)، قمّ :
مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث.
8. رجال السيّد بحر العلوم، محمّد مهدي بحر العلوم النجفي (ت 1212 ه)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: مكتبة العلمين، أعادته مطبعة الصادق - طهران.
9. رجال الطوسي، محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية، 1380 ه.
ص: 133
10. رجال العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (ت 726 ه)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية، 1381 ه.
11. رجال النجاشي، أحمد بن علي أبو العبّاس النجاشي البغدادي (ت 450 ه)، تحقيق:
موسى الشبيري الزنجاني، قمّ : طبعة جماعة المدرّسين.
12. السبطان في موقفيهما، علي نقي النقوي اللكهنوي الهندي (ت 1409 ه)، قمّ : مكتبة الداوري.
13. سيرة آية اللّٰه الخراساني (ت 1368 ه)، تأليف لجنة التأبين، تمهيداً له بمناسبة مرور نصف قرن على وفاته، قمّ : مطبعة باقري، 1415 ه.
14. الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي (الفروع)، ثامر هاشم حبيب العميدي، قمّ : مركز النشر في مكتب الإعلام الإسلامي، 1414 ه.
15. عروض البلاء على الأولياء، محمّد هادي الحسيني الخراساني الحائري (ت 1368 ه)، تحقيق محمّد رضا الحسيني الجلالي، نشر في مجلّة تراثنا العدد 37.
16. الفهرست، محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية.
17. الكافي (قسم الأُصول)، أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي البغدادي (ت 329 ه)، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفّاري، بيروت: دار الأضواء، 1405 ه.
18. الكنىٰ والألقاب، عبّاس القمّي، قمّ : مكتبة بيدار، مصوّرة عن طبعة صيدا، 1358 ه.
19. لسان العرب، محمّد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي، مصر: دار المعارف.
20. متشابه القرآن ومختلفه، محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني السروي (ت 588 ه)، تصحيح: حسن المصطفوي، قمّ : مكتبة بيدار، 1410 ه.
21. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمّد باقر بن محمّد تقي الأصفهاني المعروف بالعلّامة المجلسي (ت 1110 ه)، إخراج ومقابلة وتصحيح: هاشم الرسولي، طهران: دار الكتب الإسلامية، 1402 ه.
ص: 134
22. المستدرك على الصحيحين، محمّد بن عبد اللّٰه بن البيّع المعروف بالحاكم النيسابوري (ت 405 ه)، طبع حيدر آباد في 4 أجزاء.
23. معالم العلماء، ابن شهر آشوب السروي (ت 588 ه)، تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية، 1381 ه.
24. معجم الأعلام من آل زرارة الكرام، محمّد رضا الحسيني الجلالي، طُبع مع رسالة أبي غالب الزراري، قمّ : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية التابع لمكتب الإعلام المركزي، 1411 ه.
25. مقتل الحسين عليه السلام، عبد الرزّاق الموسوي المقرّم، قمّ : دار الثقافة، 1411 ه.
ص: 135
ص: 136
لماذا القصص القرآني ؟
حياة البشر تمضي إلى الإمام، وقائع تتنوّع، أحداث تتجدّد، ومنها ينسج التاريخ القديم والجديد على حدٍّ سواء:
ومن وعى التاريخ في صدره *** أضاف أعماراً إلى عمره
والقصّة تبرز بين ألوان الأساليب الهادفة، من بين وسائل الإيضاح والكشف والإبانة، لتضع بين يدي طالبي الحقيقة وقائع الحياة، مرّها وحلوها: «لَقَدْ كٰانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي اَلْأَلْبٰابِ »(2) .
إنّ في قصص البشر لعبرة واعتبار لمن يعتبر، وقد نُقل عن الإمام عليّ عليه السلام:
ما أكثر العبر وأقلّ الاعتبار(3).
ص: 137
فهل نكون من الكثرة التي تلتذّ بقراءة القصص وتستمرئ وحسب ؟ هل نكون من هؤلاء الذين يعلمون ولا يعملون، ويعظون ولا يتّعظون، ويقولون ما لا يفعلون ؟! أم نكون من القلّة الصابرة الشاكرة، النقيّة التقيّة، الذين يفعلون ما يقولون، ويفعلون ما لا يقولون، الذين يتسلّقون الجبال الشواهق بكفاءة عالية، حتّى يصلوا إلى القمم السامقة التي ينحدر عنها السيل ولا يرقى إليها الطير، كما يقول أمير البلاغة والبيان أمير المؤمنين عليه السلام ؟
إنّ القصّة سجل حافل بألوان التجارب البشرية المضغوطة؛ لإنارة الطريق لكلّ السالكين الحاضرين والآتين من الأجيال بعدهم.
وقد قرأت قصص الكافي عدّة مرات قراءة متأنّية، فوجدت فيها المتعة والفائدة؛ لأنّها لم تكن قصصاً خيالية، وإنّما هي قصص واقعية تأتي أُكلها كلّ حين، لمن أراد الاعتبار، ذلك أنّ بعض أبطال وشخوص القصص هم من أعلى القمم في السلوك العرفاني والتعامل المعنوي الأخلاقي والتواضع الإنساني، وقد نقل الإمام الخميني الراحل عن أحد أساتذته: «من الصعب أن تكون عالماً، ومن الأصعب أن تصبح إنساناً»(1).
والقصص المدوّنة في الكافي والمنتزعة من صميم وقائع الحياة، تريد منّا أن نكون إنسانيّين، أن نكون كما يريد خالقنا أن نكون، أن نكون صوراً مصغّرة تتمثّل فينا معاني الإنسانية، ولهذا نجد كتاب اللّٰه المجيد يجعل القصّة جزءاً أساسياً منه، فيذكر قصص الأنبياء: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وآدم ويوسف، وغيرهم ممّن أناروا طريق البشرية المعذّبة بأخلاقياتهم وإيمانهم وعلمهم، ويكرّر ذكرها؛ لعظيم فائدتها لكلّ المستويات العالية والمتوسّطة والدانية، ليشدّهم جميعاً إلى ما يريد،
ص: 138
ولا يريد اللّٰه إلّاالخير والفضل والسعادة والتألّق والسموّ والرفعة لعباده، والتصوير هو قاعدة التعبير في كتاب اللّٰه(1)، كما هو قاعدة التعبير في قصص الكافي وغيرها من القصص.
وفيما يلي مصاديق ذلك واضحة في «قصص الكافي» التي تعتبر أساليبها من السهل الممتنع، سهلة من جهة التعبير والتصوير، إلّاأنّها القصص التي انتُزعت من وقائع الحياة، وأُشبعت بالأخلاق المناقبية العالية التي تجسّدت على الأرض، قبل أن تُحكى باللسان أو تُكتب على الورق، ومن اللّٰه نستمدّ العون والتوفيق والسداد.
بينما كان يستعرض صور ماضيه المليء بالمشقّة ويتذكّر الأيّام المرّة التي خلّفها وراءه، كالأيّام التي لم يكن قادراً فيها على الحصول على القوت اليومي لزوجته وأطفاله المساكين، بينما كان كذلك، وإذا بحديثٍ سمعه من قبل يطرق سمعه ثلاث مرّات، ممّا بعث فيه العزم وغيّر مسيرة حياته، وأنقذه مع عائلته من أسر الفقر والنكبة.
فبعد أن رأت زوجته أنّ الفقر المدقع قد بلغ أوجه، أشارت عليه بأن يذهب إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ويعلمه بحالته المادّية المتدهورة تلك، ويطلب منه العون والمساعدة.
فمضى من ساعته إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ليخبره بما اقترحت عليه زوجته، وقبل أن يتفوّه بحاجته، سمع هذا الحديث من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه اللّٰه»(2)، فلم يقل شيئاً، وعاد إلى بيته بخفيّ حنين. ومن شدّة وطأة الفقر اضطرّ إلى أن يذهب إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في اليوم التالي لطلب المساعدة، وإذا بالحديث نفسه يطرق سمعه
ص: 139
للمرّة الثانية: «من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه اللّٰه»، وعاد كما في المرّة الاُولى إلى بيته من دون أن يظهر حاجته، إلّاأنّه وجد نفسه في قبضة الفقر لا مناص منها، فنهض قاصداً النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم للمرّة الثالثة. وما أن سمع حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم حتّى غمر الاطمئنان قلبه؛ لأنّه أحسّ بأنّ مفتاح مشكلته بيده، فخرج وهو يسير بخطوات واثقة مردّداً في نفسه: لن أطلب معونه العبيد أبداً، سأعتمد على اللّٰه وأتوكّل عليه، فهو حسبي، وسأستعين بما وهبني عزّ وجلّ من قوّة، وما التوفيق إلّامن عند اللّٰه.
وبينما هو فى غمرة الأفكار استوقفه سؤال: ترى ما العمل الذي بمقدورى أن أعمله ؟ وفجأة خطر له أن يذهب إلى الصحراء ويحتطب، فاستعار معولاً وشقّ طريقه نحو الصحراء. جمع مقداراً من الحطب، جاء به إلى المدينة، باعه، فذاق لذّة تعبه وحلاوة كدحه.
ولم يزل هذا ديدنه حتّى استطاع أن يشتري له ناقة وغلامين، وكلّ ما يحتاجه من لوازم لعمله، وإذا به يصبح ذا ثراء وغلمان. وذات يوم التقى النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم وأخبره خبره وكيف أنّه جاءه لطلب المساعدة، فابتسم النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم وقال: أتذكر أنّني قلت حينها: «من سألنا أعطيناه، ومن استغنى اغناه اللّٰه»؟
فأنت - أيّها القارئ النبيه - تلاحظ فى هذه القصّة ما يلى:
1 - تلاحظ الحاجة الملحّة الضاغطة التي ألجأته إلى الذهاب إلى رسول اللّٰه لطلب المساعدة والعون.
2 - وتلاحظ دور المرأة التحريضي لزوجها بالذهاب إلى النبيّ لطلب المساعدة والعون.
3 - كما تجد استجابته لطلب زوجته بالذهاب لإنقاذ الحالة المزرية.
4 - وتلاحظ أيضاً إسراعه بالذهاب إلى المسجد؛ لأنّه لم يجد بداً من ذلك، لظنّه أنّ طلب المساعدة من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم هو المخرج الوحيد الذي لا مخرج سواه؛ لأزمته التي أحكمت حصارها عليه وعلى أفراد عائلته قاطبةً .
ص: 140
وحين وصوله إلى المسجد يفاجأ بسماعه لحديث رسول اللّٰه: «من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه اللّٰه»، وهو حديث يحكي حالته المعاشة، ويوجد فيه مفتاح الحلّ في القسم الثاني منه «ومن استغنى أغناه اللّٰه».
5 - ونجده حينما يسمع الحديث النبويّ المنقذ، يعود أدراجه إلى البيت، ولم يتفوّه بشيء.
6 - ولكنّنا كذلك نلاحظه في مشهدٍ آخر يعود ثانية إلى الرسول في اليوم الثاني تحت إلحاح الحاجة وإلحاح الزوجة، إلّاأنّه كذلك يسمع ما سمعه في المرّة الاُولى.
7 - وهكذا نلاحظ الرجل الفقير يذهب ثالثةً ، فلا يسمع شيئاً غير الحديث الذي سمعه في المرّة الاُولى والثانية. وهنا نجده ينتبه إلى وضعه المزري، ويرى أنّ الحلّ لمشكلته بيده، وينبع الحلّ من داخل نفسه، فالمستعان هو اللّٰه، وأمّا العبيد فهم أدوات وآلات للوصول إلى الأهداف، فاستعار معولاً، وشقّ طريقه نحو الصحراء، وجمع مقداراً من الحطب، جاء به من الصحراء إلى المدينة، فباعه، فذاق لذّة كدحه وتعبه، ولم يزل هذا عمله، حتّى استطاع أن يشتري له ناقة وغلامين، وكلّ ما يحتاجه من لوازم لعمله، وإذا به يصبح ذا ثراء وغلمان! وهذا التغيير الكبير إنّما حصل بعد أن غيّر ما بنفسه واتّخذ قرار العمل ولم يعتمد على المساعدات.
8 - وأخيراً وبعد الوصول إلى الحالة الجديدة والنقلة النوعية في حياته، التقى رسول اللّٰه الناصح الأمين، فأخبره خبره، وكيف أنّه جاء يوماً لطلب المساعدة والعون منه، فابتسم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وقال: أتذكر أنّني قلت حينها: «من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه اللّٰه»؟
وهذا يذكّرنا بذلك البدوي القادم من البادية، والذي طلب النصيحة بإيجاز من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم؛ لأنّه لا يوجد عنده وقت للمثول بين يديه في كلّ الأوقات، فقال له النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تغضب»، وحينما طلب المزيد على ذلك مرّتين، كرّر عليه رسول اللّٰه نصيحته المقتضبة «لا تغضب»! فوجد البدوي المستنصح في هذه الكلمة الواحدة كلّ
ص: 141
خير لنفسه ولمجتمعه البدوي الذي تقوم علاقاته على الانفعال والغضب والتعامل مع الآخر لأدنى الأسباب، بالسلاح وسفك الدماء، فإنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بذكائه وفطنته المميّزين اختار لهذا البدوي نصيحة مناسبة لبيئته البدوية المنفعلة الغاضبة المهتزّة، وقد استفاد منها إيما استفادة، فهو - البدوي - عندما عاد إلى أهله ودياره وجد عشيرته وقد تأهّبت للقتال مع عشيرةٍ أُخرى قد حملت السلاح هي الأُخرى، وقد أراد في بداية الأمر أن يقف إلى جنب عشيرته مقاتلاً، إلّاأنّه تذكّر نصيحة رسول اللّٰه الموجزة والغنية «لا تغضب»، فألقى سلاحه، بعد أن امتشقه! وتحوّل إلى حمامة سلام بين الطرفين، فكان السلام وكان الوئام بفضل الالتزام بنصيحة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تغضب».
كانت الكوفة فيما مضى محطّ أنظار الدولة الإسلامية، وكانت أنظار المسلمين - ما عدا الشام - متوجّهة إليها، تنتظر ما يصدر فيها من أمر وتترقّب ما يتّخذ فيها من قرار.
ومن محاسن المصادفات أن التقى خارجها، ذات يوم من الأيّام مسلم وذمّي فسأل أحدهما الآخر عن الجهة التي يطلبها.
فقال المسلم: أنا أريد الكوفة.
وقال الذمّي: أمّا أنا فأريد مكاناً قريباً منها.
ثمّ اتّفقا أن يسيرا معاً ويقطعا طريقهما بالتحدّث إلى بعضهما.
ولانسجامهما في الحديث لم يشعرا بمضيّ الوقت ولا طول الطريق، إلى أن وصلا إلى مفترق الطرق، فتعجّب الذمّي لمّا رأى أنّ رفيقه المسلم يترك طريق الكوفة ويواصل السير معه، إذ ذاك سأله: ألست زعمت أنّك تريد الكوفة ؟
قال المسلم: بلى.
قال له الذمّي: فلم عدلت إذاً؟ هذا ليس طريق الكوفة!
قال المسلم: أعلم ذلك، فمن حسن الصحبة عندنا أن يشيّع الرجل صاحبه هنيهة
ص: 142
إذا ما فارقه، وبهذا أمرنا نبيّنا محمّد صلى الله عليه و آله و سلم.
فقال الذمّي: لا غرو أن يتبعه من تبعه لإخلاقة الحميدة وأفعاله الكريمة، وها أنا أُشهدك أنّي على دينك. ورجع معه، فلمّا عرف أنّه أمير المؤمنين عليه السلام، أسلم.
1 - في المشهد الاُول من هذه القصّة نلاحظ أنّ عاصمة الدولة الإسلامية (الكوفة) كانت محطّ أقطار وبلدان الدولة الإسلامية الكبرى، ومحطّ أنظار كافّة المسلمين والمكوّنات الأُخرى للأُمّة.
2 - وفي المشهد الثاني نلاحظ من خلال هذه القصّة كيف تتعايش مكوّنات الأُمّة الدينية والقومية في الدولة الإسلامية بسلام، فهنا مسلم يرافق ذمّي في طريقٍ واحد، ويتجاذبان أطراف الحديث في أُمور شتّى، عملاً بالآية المباركة: «قُلْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلىٰ كَلِمَةٍ سَوٰاءٍ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ أَلاّٰ نَعْبُدَ إِلاَّ اَللّٰهَ وَ لاٰ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لاٰ يَتَّخِذَ بَعْضُنٰا بَعْضاً أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اَللّٰهِ ...»(1).
3 - وأمّا في المشهد الثالث فإنّنا نلاحظ بوضوح كيف يعيش قائد الدولة الإسلامية العظمى حياة البساطة والتواضع وهو يسير مع مواطن من مواطني الدولة التي تضمّ كافّة المكوّنات الدينية والقومية وغيرهما.
4 - ونلمس في المشهد الرابع الأخلاق الإلهيّة المحمّدية العالية، حينما يقوم المسلم الحقّ الحقيقي الواقعي بتشييع صاحبه الذي كان يسير معه، حينما يصلان إلى مفترق الطرق، أي إنّ رفيقه المسلم يترك طريق الكوفة ويواصل السير معه.
5 - وفي المشهد الخامس نلاحظ كيف أنّ هذه الأخلاق تجذب هذا الذمّي إلى الإسلام بدون إكراه، وهي الأخلاق التي أخذها من أُستاذه وابن عمّه خاتم الأنبياء، الذي أثنى عليه الخالق العظيم في كتابه الكريم، عندما قال: «وَ إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ »(2)،
ص: 143
فهل يلتزم المسلمون اليوم بما التزم به مسلمو الأمس ومنهم وفي مقدّمتهم المسلم الحقّ علي بن أبي طالب عليه السلام ؟ حينما استطاع تحويل ذمّي معاهد إلى دين اللّٰه الأخير بالأخلاق الإلهيّة المحمّدية، التي كان يرفع إليه أُستاذه كلّ يوم علماً منها، كما كان يقول، وهذه هي دعوة الحال، ولا شك أنّ دعوة الحال أبلغ وأشدّ تأثيراً من دعوة المقال.
عند مسيره الجهادي إلى الشام، مرّ الإمام عليّ عليه السلام بمدينة الأنبار التي كان يقطنها الفرس، فخرج لاستقباله دهاقينها وفلّاحوها، وترجّلوا والتفّوا حوله مزدحمين لشدّة استبشارهم بقدومه.
فقال عليه السلام: ما هذا الذي صنعتموه ؟
قالوا: خلق منّا نعظّم به أُمراءنا.
فقال عليه السلام: واللّٰه ما ينتفع بهذا أُمراؤكم وإنّكم لتشقّون على أنفسكم في دنياكم، وتشقّون به في آخرتكم، وما أخسر المشقّة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان في النار(1).
عند قراءتنا لهذه القصّة - وهي من قصار القصص وهي أقرب إلى الحوار منه إلى القصّة - نلاحظ ما يلي:
1 - نجد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يستقرّ في عاصمة دولته (الكوفة)، وإنّما يتجوّل في أنحاء البلاد التي يحكمها، ولو كانت بعيدة عن المركز، حسبما يقتضيه الواجب وتستدعيه المسؤولية، فيذهب إلى الأنبار (الرمادي حالياً) مروراً بالشام،
ص: 144
وكان يواجه الفتن والحروب التي أُشعلت ضدّه، وكان يلاحقها ليخمدها، وكان يقول:
لأبقرنّ الباطل بقراً حتّى أُخرج الحقّ من خاصرته(1).
2 - كان الفرس يسكنون الأنبار إلى جنب إخوتهم العرب والقوميات الأُخرى، وهذا دليل واضح على احتضان حاكم الدولة عليّ بن أبي طالب لكلّ القوميات دون تفريق وتمييز بين أبنائها، فقد كان يصدر في تصرّفاته عن القرآن والسنّة، وهما لا يميّزان الناس من خلال المكوّن القومي، فقد روت لنا المصادر التاريخية الموثوقة أنّ أُخته أُمّ هاني بنت أبي طالب دخلت على أخيها خليفة المسلمين عليّ بن أبي طالب فدفع إليها عشرين درهماً، فسألت أُمّ هاني مولاتها العجمية قائلة:
كم دفع إليك أمير المؤمنين عليه السلام ؟
فقالت: عشرين درهماً.
فانصرفت مسخطة!
فقال لها عليّ عليه السلام: انصرفي - رحمك اللّٰه - ما وجدنا في كتاب اللّٰه فضلاً لإسماعيل على إسحاق(2).
3 - وفي هذه القصّة القصيرة نشهد طريقة الاستقبال الذي استقبل به عليّ عليه السلام من كافّة الطبقات (الدهاقين والفلّاحين) فرحاً واستبشاراً بقدومه على طريقة استقبال الحكّام الطغاة من قبل الناس، وهي طريقة جاهلية، وخلق جاهلي، لا يمتّ إلى الإسلام بصلة من قريبٍ أو بعيد! فقد كان الناس أيّام الطاغية(3)، حينما يحلّ بمكان، يركض وراءه الناس وهم يردّدون: (هلة بيك هلة، وبجيّتك هلة)! لكن عليّ الحقّ والقرآن والإسلام، يرفض ويستنكر هذه الطريقة الجاهلية في الاستقبال، فيسأل المستقبلين مستنكراً: «ما هذا الذي صنعتموه ؟!».
ص: 145
فيجيبون: خلق منّا نعظّم به أُمراءنا! فيرفض هذا الأُسلوب؛ لأنّه مشقّة لهم، وليس فيه فائدة للأُمراء، وهو شقاء في الآخرة، ولو كان غير عليّ من الحكّام الظالمين لأهلّوا واستهلّوا فرحاً!
دخل رجل فقير ليس عليه ما يستره، على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وهو جالس بين أصحابه، وإلى جانبه رجل موسر، ما أن رأى الفقير بهذه الهيئة حتّى جمع أطراف ثيابه دون علم منه أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يراقبه، فقال له النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: جمعت أذيالك، أخفت أن يمسّك من فقره شيء؟
قال: لا.
قال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: أخفت أن يصيبه من غناك شيء؟
قال: لا.
فقال صلى الله عليه و آله و سلم: فما حملك على ما صنعت ؟
قال: يا رسول اللّٰه، إنّ لي قريناً شيطاناً، يزيّن لي كلّ قبيح، ويقبّح لي كلّ حسن.
واستطرد - الموسر - قائلاً: أعترف بأنّني مخطئ، وأنا مستعدّ أن أكفّر عن الخطأ الذي قمت به تجاهه، بأن أهب له نصف ما أملك.
فقال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم للمعسر: أتقبل ؟
قال: لا.
فقال له الرجل الموسر متعجّباً: ولم ؟
قال: أخاف أن يداخلني ما داخلك من الكبر والتكبّر!
عند قراءة هذه القصّة في أُصول الكافي، نجد فيها المشاهد والصور التالية:
1 - المشهد الاُول والصورة الاُولى، مشهد وصورة اجتماع الفقراء مع الأغنياء، ورسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يستقبل هاتين الطبقتين معاً دون تمييز، وهذا المشهد كما نجده في الصلاة جماعةً وفي الحجّ ، نجده في الواقع العملي الحياتي.
ص: 146
2 - كما نجد في هذه الصورة مشهداً آخر نشازاً، هو تكبّر الغني الموسر الجالس إلى جنب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، وكيف أنّه لملم أطراف ثيابه عندما جلس الفقير إلى جنبه! وهو من بقايا الأخلاق الجاهلية التي تقيس حجم الإنسان وقيمته بما يملك من مال، وليس بالتقوى وبالعلم والأخلاق وما إلى ذلك من قيم للتفاضل وضعها الإسلام، عند التفاضل بين إنسانٍ وآخر!
3 - وفي مشهدٍ وصورة ثالثة نلاحظ كيف أنّ رسول اللّٰه قد اغتنم الفرصة عندما لمس حركة المسلم الغني وانكماشه على أخيه المسلم الفقير، فوجّه أسئلة محرجة إلى المسلم الغني الذي تكبّر على أخيه المسلم الفقير عندما جمع أطراف ثيابه!
4 - وفي مشهدٍ رابع من مشاهد هذه القصّة القصيرة المعبّرة والمصوّرة، نجد التأثّر الواضح الذي ظهر فوراً على الرجل المسلم الموسر، حيث أبدى استعداده للتكفير عن خطئه، وذلك بإعطاء نصف ثروته إلى المسلم الفقير المعسر، وهذا يذكّرنا بقول شهير يقول: إذا خرجت الكلمة من القلب دخلت إلى القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتعد الأذان.
5 - وفي مشهدٍ وصورة ختامية يوجّه رسول اللّٰه السؤال إلى المسلم المعسر الفقير، بعد أن استمع إلى العرض السخي الذي تقدّم به المسلم الموسر، يوجّه رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم سؤاله إلى المسلم المعسر فيما إذا كان يقبل بهذا العرض أم لا؟ فيكون جوابه: كلّا! وفي وسط هذا التعجّب الذي بدى على وجه الرجل الموسر، يسأله المسلم الثري عن السبب، فيقول المسلم المعسر مجيباً: إنّي أخشى إذا امتلأت جيوبي بالمال أن أفقد توازني وأصبح متكبّراً مثلك؛ لأنّ المال في الواقع وفي نظر المنهج الإلهي لا يمثّل قيمة ذاتية - بحدّ ذاته - والإنسان مستخلف فيه، وقد جاء في كتاب اللّٰه: «وَ أَنْفِقُوا مِمّٰا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ »(1) ، وأيضاً: «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِي
ص: 147
آتٰاكُمْ »(1) ، وقد سُئلت أعرابية بدوية ثرية عن المال الذي تملكه فقالت: «للّٰه في يدي»، وقد جاء على لسان أحد الشعراء قوله:
إنّ الشباب والفراغ والجدّة *** مفسدة للمرء أي مفسدة
جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فشكا إليه أذىً من جاره، فقال له النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: اصبر، لعلّه يغيّر طريقته. وبعد مدّة جاءه مرّة ثانية، فقال له النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: اصبر!
ثمّ جاء مرّة ثالثة، فقال له النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: إذا كان يوم الجمعة اخرج أثاث بيتك وضعه على قارعة الطريق حتّى يراه من يذهب لصلاة الجمعة، فإذا سألوك فاخبرهم بالخبر. ففعل الرجل بوصية الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، فأتاه جاره معتذراً، وقال له: ردّ متاعك إلى بيتك، فلك اللّٰه عليّ أن لا أعود(2).
عندما نقرأ هذه القصّة من قصص الكافي، ونمعن النظر فيها ونقرأ أمثالها، نجد المشاهد والصور التالية فيها:
1 - نجد صورة ذلك الرجل الذي لحق به الأذى من جاره، وفاق الأذى الحدود، فيأتي لرسول اللّٰه شاكياً، إلّاأنّ الرسول يأمره بالصبر على الأذى، فقد يغيّر طريقته، وقد جاء في الأحاديث الشريفة:
ليس حسن الجوار كفّ الأذى عن الجار، ولكنّ حسن الجوار هو الصبر على الأذى(3).
2 - ونجد صورة ثانية يعود فيها الجار المُعنى شاكياً إلى رسول اللّٰه، إذ لم ينفع معه
ص: 148
الصبر في الاُولى، فيطالبه وينصحه كذلك بالصبر.
3 - ونجد في هذه القصّة القصيرة صورة ومشهداً آخر - هو آخر المشاهد - حيث يعود الرجل للمرّة الثالثة لرسول اللّٰه شاكياً إليه استمرار الإيذاء من جار السوء، فينصحه خاتم الأنبياء هذه المرّة بطريقة للاحتجاج على سوء تصرّف جاره معه، فقد نصحه بإخراج أثاث بيته ووضعه على قارعة الطريق، حتّى يرى ذلك كلّ من يذهب إلى صلاة الجمعة، فإن سال المارّون للصلاة منه عن هذا العمل، أجابهم بواقع الحال، وكانت هذه وسيلة للاحتجاج ناجحة، حيث أحرج جار السوء أمام المارّين، فاعتذر من المشتكي وقال له: ردّ متاعك إلى بيتك، فلك اللّٰه عليّ أن لا أعود!
وممّا يلفت الانتباه هو أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم كان يؤكّد على الرجل المشتكي عنده من جاره، كان يؤكّد على الصبر، وهي صفة ذات قيمة إيجابية عليا في المنظومة الإلهيّة الأخلاقية، فهذا كتاب اللّٰه المجيد يؤكّد عليها حينما يقول مثلاً: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ اَلصَّلاٰةِ إِنَّ اَللّٰهَ مَعَ اَلصّٰابِرِينَ »(1) ، فخير ما يُستعان به على ملمّات وأعباء الحياة هو الصبر، وقد جاء كذلك في الكتاب المبين قوله تعالى: «إِنَّمٰا يُوَفَّى اَلصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ »(2) ، وغير ذلك من الآيات.
وأمّا الروايات التي رويت عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته، فهي كثيرة لا تعدّ ولا تحصى، وهي تحثّ على الاتّصاف بهذه الصفة الضرورية في حياتنا الفردية والاجتماعية، وهاك بعضها:
قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم:
الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عند المصيبة(3).
وقال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام:
ص: 149
الصبر صبران: صبر على ما تكره، وصبر عمّا تحبّ (1).
وقال الإمام الباقر عليه السلام:
الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة(2).
قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام:
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان(3).
قال أبو جعفر عليه السلام:
الجنّة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنّة، وجهنّم محفوفة باللذّات والشهوات، فمن أعطى نفسه لذّتها وشهوتها دخل النار(4).
وورد عن عليّ عليه السلام، وهو يعزّي الأشعث بن قيس بفقد ولده:
إنّك إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى القدر وأنت مأزور(5).
وجاء عنه أيضا عليه السلام:
الصبر مطيّة لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو(6).
وعنه عليه السلام:
من ابتُلي من المؤمنين ببلاءٍ فصبر عليه، كان له مثل أجر ألف شهيد(7).
وقال عيسى عليه السلام:
ص: 150
إنّكم لا تدركون ما تحبّون، إلّابصبركم على ما تكرهون(1).
وجاء عنه عليه السلام:
لا يعدم الصبور الظفر، وإن طال به الزمان(2).
وأمّا ما جاء في الشعر فهو كثير كثير، ومنه:
بنى اللّٰه للأحرار بيتاً سماؤه *** هموم وأحزان وحيطانه الضرّ
وأدخلهم فيه وأغلق بابه *** وقال لهم مفتاح بابكم الصبر(3)
ونُسب إلى عليّ أمير المؤمنين عليه السلام قوله:
إنّي وجدت وفي الأيّام تجربة *** للصبر عاقبة محمودة الأثر
فقلّ من جدّ في أمرٍ يطالبه *** فاستصحب الصبر إلّافاز بالظفر(4)
ونُسب أيضاً لعليّ عليه السلام:
أخي لن تنال العلم إلّابستّة *** سأنبّيك عن مجموعها ببيان
ذكاء وحرص واصطبار وبلغة *** وإرشاد أُستاذ وطول زمان(5)
وقال شاعر آخر:
إذا ضاق الزمان عليك فاصبر *** ولا تيأس من الفرج القريب
وطب نفساً بما تلد الليالي *** عسى تأتيك بالأمر العجيب
وقال آخر:
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته *** ومدمن القرع للأبواب أن يلجا(6)
ص: 151
وقال ابن الرومي:
اصبري أيّتها النفس *** فإنّ الصبر أحجى
ربّما خاب رجاء *** وأتى ما ليس يرجى(1)
وهكذا تمضي الآيات والروايات والأبيات تمجّد الصبر وتدعو إليه؛ لأنّه الوسيلة المجرّبة حياتياً، والوصفة الطبّية الإلهيّة لكافّة الشؤون؛ ولأنّه السلاح الذي لابدّ منه في كلّ الحالات والأوضاع (الطاعة والمعصية والابتلاء)، ولهذا نجد الرسول الأعظم يؤكّد للرجل الذي كان يؤذيه جاره بالصبر!
لم يوفّق الطلّاب للإجابة على السؤال الذي طرحه أُستاذهم، فلقد أجاب كلّ واحد منهم جواباً لم يقع موقع القبول لدى الأُستاذ.
كان سؤال أُستاذهم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم هو: أيّ عرى الإيمان أوثق ؟
أجابه واحد من الصحابة: الصلاة.
النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: لا.
أجاب آخر: الزكاة.
النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم: لا.
أجاب ثالث: الصوم.
النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم: لا.
وقال رابع: الحجّ والعمرة.
النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم: لا.
أمّا الخامس فقال: الجهاد.
ص: 152
النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: لا.
كانت النتيجة أنّ الجواب المطلوب لم يصدر من أحد من الطلّاب الحاضرين، بل صدر من المعلّم نفسه، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: لكلّ ما قلتم فضل، ولكن ليس المطلوب ما قلتم.
إنّ أوثق عرى الإيمان الحبّ في اللّٰه والبغض في اللّٰه(1).
عند مطالعة هذه القصّة القصيرة جدّاً نجد مشاهد ثلاثة تلفت انتباه القارئ أو السامع للقصّة:
1 - المشهد الاُول فيها هو إثارة سؤال هامّ ، يُراد به الوصول إلى الجواب الصحيح منه، والسؤال المثار من قبل المعلّم هو: «أي عرى الإيمان أوثق ؟»، وقد قلنا إنّ هذه الطريقة في إثارة السؤال أو الأسئلة طريقة قرآنية نبويّة، في تحليل سابق لقصّة مضت من قصص الكافي، وهي طريقة تستهدف أمرين أساسيّين: الاُول منهما الوصول إلى الحقيقة، والثاني هو إشراك التلاميذ أو مجموعة من الناس الذين أُثير السؤال الممهمّ بالتفكير وتحريك أذهانهم.
فمن أمثلة الأسئلة القرآنية المثارة: «هَلْ جَزٰاءُ اَلْإِحْسٰانِ إِلاَّ اَلْإِحْسٰانُ »(2)؟
وقد تكرّر سؤال واحد هو: «فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ » في سورة واحدة هي سورة الرحمان (31) مرّة؛ لأهمّية هذا الأُسلوب في طرح الحقائق، والإشارة إليها.
ومن أمثلة الأسئلة المثارة في السنّة: «ألا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم ؟
قالوا: بلى يا رسول اللّٰه.
قال صلى الله عليه و آله و سلم: افشوا السلام بينكم»(3).
ومن أمثلة ذلك قول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يخاطب بعض أصحابه: «أيحبّ أحدكم أن تكون على عتبة داره حمّة، يغتسل فيها كلّ يوم خمس مرّات فلا يبقى من درنه شيء؟
قالوا: بلى يا رسول اللّٰه.
ص: 153
قال صلى الله عليه و آله و سلم: إنّها الصلوات الخمس»(1).
وهذه الطريقة في إثارة الأسئلة أقرّها التربويّون قديماً وحديثاً، وعملوا بها، وقد كان الفيلسوف اليوناني سقراط يعمل بها، وكان يقول: إنّ أُمّي كانت تولد الأجنّة من بطون الحوامل، وأنا أولّد الحقائق من الناس من خلال إثارة الأسئلة!
2 - المشهد الثاني في هذه القصّة القصيرة هو عدم وصول الطلّاب إلى إجابة صحيحة على السؤال الذي وجّهه إليهم الأُستاذ، فليست الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والعمرة والجهاد هي أوثق عرى الإيمان كما أفادوا، رغم ما لها من فضل، فالتلاميذ في هذا المشهد لم يصلوا إلى الإجابة الصحيحة رغم تعدّدها.
3 - وفي مشهد أخير في القصّة يقدّم لهم الأُستاذ الجواب الصحيح على السؤال المطروح أمامهم، بعد هذا الحوار القصير معهم، وبعد الاستماع إليهم، يقدّم لهم الإجابة الصائبة، هل سؤاله الهادف «أيّ عرى الإيمان أوثق ؟»، يقدّم الجواب بعد اختبارهم فيقول: «أوثق عرى الإيمان الحبّ في اللّٰه والبغض في اللّٰه»، أن تحبّ أخاك لا لطمعٍ فيه، ولا لخوفٍ منه، إنّما تحبّه لخصلة أو خصال فيه يحبّها اللّٰه، كأن يكون إنساناً معواناً للمحاويج من الناس... وكذلك لا تبغض أحداً انطلاقاً من المزاج، لا تبغض أحداً لأنّه قصير القامة، أو لأنّه أسود اللون، أو لأنّه ينتمي إلى قومية غير قوميتك، أو إلى بلدٍ لا تحبّه، إنّما تبغضه لوجود صفات فيه لا يحبّها اللّٰه، كأن يكون مغتاباً أو نمّاماً أو كذّاباً وما إلى ذلك من الخصال المبغوضة عند اللّٰه كما يراها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، إنّ رسول اللّٰه يرى أنّ أوثق عرى الإيمان هو «الحبّ في اللّٰه والبغض في اللّٰه».
كان جويبر رجلاً قصيراً ذميماً، محتاجاً عارياً، وكان أسوداً من قباح السودان، وكان من أهل اليمامة. جاء إلى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم طالباً الإسلام، فأسلم على يده صلى الله عليه و آله و سلم، وحَسُن
ص: 154
إسلامه.
ضمّه رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لحال غربته واحتياجه، فكان يجري عليه طعاماً صاعاً من تمر، وكساه شملتين، وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه في الليل، فمكث هناك ما شاء اللّٰه، حتّى كثر الغرباء ممّن يدخلون في الإسلام، من أهل الحاجة بالمدينة، إلى أن ضاق بهم المسجد، فأوحى اللّٰه عزّ وجلّ إلى نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم أن طهّر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل.
أمر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بعد ذلك أن يتّخذ المسلمون سقيفة، فعملت لهم وهي الصفّة، ثمّ أمر الغرباء والمساكين أن يظلّوا فيها نهارهم وليلهم، فنزلوا واجتمعوا فيها، فكان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يتعهّدهم بالبرّ والتمر والشعير والزبيب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وكان المسلمون يتعهّدونهم ويرقّون عليهم لرقّة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.
نظر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إلى جويبر ذات يوم، وقال له:
يا جويبر، لو تزوّجت امرأةً فعففت بها فرجك، وأعانتك على دنياك وآخرتك.
فقال جويبر: يا رسول اللّٰه، بأبي أنت وأُمّي، من يرغب فيَّ ، فواللّٰه ما من حسبٍ ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأيّة امرأة ترغب بي ؟
فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم:
يا جويبر، إنّ اللّٰه قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفاً، وشرّف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعاً، وأعزّ بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلاً، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلّهم، أبيضهم وأسودهم وقرشيهم، وعربيهم وأعجميهم من آدم وأنّ آدم خلقه اللّٰه من طين، وأنّ أحبّ الناس إلى اللّٰه عزّ وجلّ يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لأحدٍ من المسلمين عليك اليوم فضلاً، إلّالمن كان أتقى للّٰه منك وأطوع.
ثمّ قال له:
انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنّه من أشرف بني بياضة حسباً - وهي قبيلة من الأنصار - وقل له: إنّي رسول رسول اللّٰه إليك، وهو يقول لك: زوّج جويبراً ابنتك الذلفاء.
ص: 155
انطلق جويبر برسالة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إلى زياد بن لبيد وهو في منزله، ورهط من قومه لديه، فاستأذنه بالدخول، فأذن له، فدخل فسلّم عليه، ثمّ قال: يا زياد بن لبيد، إنّي رسول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إليك في حاجةٍ لي، أفأبوح بها أم أسرّها إليك ؟
فقال له زياد: بل بح بها، فإنّ ذلك شرف لي وفخر، فقال له جويبر: إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يقول لكم زوّج جويبراً ابنتك الذلفاء. فقال له زياد: أرسول اللّٰه أرسلك إليَّ بهذا؟
- نعم، فما كنت لأكذب على رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم.
فقال له زياد: إنّا لا نزوّج فتياتنا إلّاأكفّاءنا من الأنصار.
ثمّ قال له: انصرف يا جويبر حتّى ألقى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فأخبره بعذري.
انصرف جويبر وهو يقول: واللّٰه ما بهذا نزل القرآن ولا بهذا ظهرت نبوّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم.
فسمعت مقالته الذلفاء بنت زياد وهي في خدرها، فأرسلت إلى أبيها تستدعيه، فدخل إليها، فقالت له: ما هذا الكلام الذي سمعتك تحاور به جويبراً؟
فقال لها: ذكر لي أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أرسله، وقال: يقول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: زوّج جويبراً ابنتك الذلفاء.
فقالت له: واللّٰه ما كان جويبراً ليكذب على رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بحضرته، فابعث الآن رسولاً يردّ عليك جويبراً.
فبعث زياد رسولاً فلحق جويبراً وجاء به، فقال له زياد: يا جويبر مرحباً بك، اطمئنّ حتّى أعود إليك.
ثمّ انطلق زياد إلى رسول اللّٰه فقال له: بأبي أنت وأُمّي أنّ جويبراً أتاني برسالتك وقال: إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يقول لك: زوّج جويبراً لابنتك الذلفاء، فلم ألن له بالقول، ورأيت لقاءك، ونحن لا نزوّج فتياتنا إلّاأكفّاءنا من الأنصار.
فقال له رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: يا زياد، جويبر مؤمن، والمؤمن كفو للمؤمنة، والمسلم
ص: 156
كفو للمسلمة، زوّجه يا زياد ولا ترغب عنه.
رجع زياد إلى منزله ودخل على ابنته، فقال لها ما سمعه من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، فقالت له: إنّك إن عصيت رسول اللّٰه كفرت، فزوّج جويبراً. فخرج زياد فأخذ بيد جويبر، ثمّ إلى قومه، وزوّجه على سنّة اللّٰه وسنّة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، وضمن صداقه.
جهّز زياد ابنته الذلفاء وهيّأها، ثمّ أرسلوا على جويبر فقالوا له: ألك منزل فنسوقها إليك ؟ فقال: واللّٰه ما من منزل.
فهيّأوا لجويبر منزلاً وأثّثوه بالفراش والمتاع، وكسوا جويبراً ثوبين، وأُدخلت الذلفاء بيتها، وأُدخل جويبراً عليها.
فلمّا رآها ورأى ما منحه اللّٰه من نعمة قام إلى زاوية البيت، فلم يزل تالياً للقرآن راكعاً ساجداً حتّى طلع الفجر، فلمّا سمع النداء خرج وخرجت زوجته إلى الصلاة، فسُئلت: هل مسّكِ؟ فقالت: ما زال تالياً للقرآن وراكعاً حتّى سمع النداء فخرج.
وهكذا كانت الحال في الليلة الثانية والثالثة، فلمّا كان اليوم الثالث أُخبر أبوها بالخبر، فانطلق إلى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وحكى له ما كان من أمر جويبر.
فأرسل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إلى جويبر يطلبه، فلمّا حضر قال صلى الله عليه و آله و سلم: أما تقرب النساء؟
فأجاب جويبر: أوما أنا بفحل! إنّي لنهم إلى النساء يا رسول اللّٰه.
فقال صلى الله عليه و آله و سلم: قد خُبرت بخلاف ما وصفت به نفسك، وقد هيّأوا لك بيتاً وفراشاً ومتاعاً.
فأجاب جويبر: يا رسول اللّٰه، دخلت بيتاً واسعاً ورأيت فراشاً ومتاعاً، ودخلت عليَّ فتاة حسناء، فذكرت حالي التي كنت عليها وغربتي وحاجتي وضيعتي وكسوتي مع الغرباء والمساكين، فأحببت إذ أولاني اللّٰه ذلك، أن أشكره على ما أعطاني وأتقرّب إليه بحقيقة الشكر، فرأيت أن أقضي الليل مصلّياً والنهار صائماً، ففعلت ذلك ثلاثة أيّام ولياليها، ولكنّي سأرضيها وأرضيهم الليلة.
فأرسل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إلى زياد فأتاه، فأعلمه ما قال جويبر.
وفى جويبر بقوله، وعاش مع زوجته بسعادة وأنس وصفاء، إلى أن خرج
ص: 157
النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إلى غزوة، فخرج معه فاستشهد، وبعد استشهاد جويبر، لم تكن في الأنصار امرأة حرّة أروج في رغبة الناس إلى الزواج منها، وبذل الأموال الطائلة في الحظوة بها من الذلفاء(1).
القصّة المذكورة تعالج قضية اجتماعية أيّام رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، ويعيشها الناس في أيّامنا هذه... وهي المقاييس الخاطئة في الزواج، والمقاييس السليمة فيه، وهي قضية مهمّة جدّاً في الحياة، وأساسية وضرورية، وليست قضية هامشية.
وفيما يلي مشاهد هذه القصّة الموحية المعبّرة المصوّرة:
1 - تبدأ القصّة بذكر صفات الرجل (جويبر)، وهذا الاسم هو تصغير (جابر)، تبدأ القصّة بذكر صفاته الجسدية، فهو رجل قصير، وهو كذلك ذميم الخلقة، وهو فقير مادّياً إلى حدّ العري، وهو أسود اللون، ومن قباح السود، وهو أيضاً من أهل اليمامة وليس من أهل الحجاز، فهو غريب، وقد قدم إلى مركز الدولة الإسلامية المحمّدية المدينة المنوّرة إبان وجود قائد الدولة وخاتم الأنبياء محمّد بن عبد اللّٰه، طالباً الإسلام الذي وجد فيه نفسه وعزّته وكرامته، فأسلم علي يدي رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وحَسُن إسلامه.
2 - ونجد في مشهدٍ ثان الرعاية النبويّة الكاملة لهذا الإنسان الغريب المسلم، فكان خاتم الأنبياء يقدّم له الطعام والكساء والمنام ليلاً في المسجد النبويّ ، وكان يقدّم له الرعاية الأبوية الأخلاقية المعنوية والعاطفية والرفق في المعاملة له ولغيره. وعندما كثر الغرباء من أمثال جويبر وضاق بهم المسجد، أمر رسول اللّٰه بأمرٍ من ربّه أن يختار لهم مكاناً آخر غير المسجد، فاتّخذت سقيفة وهي (الصفّة) خارج المسجد(2)، واستمرّت الرعاية النبويّة المادّية والمعنوية لهؤلاء الغرباء ومنهم جويبر.
3 - وفي مشهدٍ ثالث في مشاهد هذه القصّة يعرض رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فكرة الزواج
ص: 158
على (جويبر) المعدم، وتأسيس عائلة ليحرز نصف دينه، إلّاأنّ جويبر يشكّ في أمر قبوله من إحدى النساء، حيث لا نسب ولا حسب ولا مال ولا جمال! وهي المقاييس الجاهلية التي تواضع عليها الناس، لكنّ الرسول الأعظم يصحّح لجويبر هذه النظرة الخاطئة، وهذه المقاييس الجاهلية، فيقول له: يا جويبر، إنّ اللّٰه قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية - قبل بزوغ فجر الإسلام - شريفاً - كأبي لهب وأبي سفيان والوليد -، وشرّف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعاً - كبلال وصهيب -، وأعزّ بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلاً، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلّهم - بكلّ قومياتهم وطبقاتهم وألوانهم وبلدانهم وأجناسهم - أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وأعجميهم، من آدم - وأنّ آدم خلقه اللّٰه من طين - وأنّ أحبّ الناس إلى اللّٰه عزّ وجلّ يوم القيامة أطوعه له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين - مهما علا نسبه وحسبه وكثر ماله وبان جماله - عليك اليوم فضلاً، إلّالمن كان أتقى للّٰه منك وأطوع!
ففي هذا المشهد يرفض رسول اللّٰه مقاييس الجاهلية في التفاضل بين الناس، ويؤكّد المقاييس الإلٰهيّة في ذلك، وهي التقوى والطاعة للّٰه، ويرفض النظرة الخاطئة لمقاييس التفاضل، سواء تلك التي يحملها زياد بن لبيد، أو غيره!
4 - في المشهد الرابع من هذه القصّة الجميلة القصيرة يبدأ خاتم الأنبياء - بعد عرض فكرة الزواج على جويبر أو التحاور معه حول المقاييس الجاهلية الخاطئة والمقاييس الإلهيّة السليمة - يبدأ بأمره باتّخاذ خطوة عملية، وذلك بالذهاب والانطلاق إلى بيت زياد بن لبيد الأنصاري، فهو من أشرف بني بياضة حسباً، وهي قبيلة من الأنصار، ليحمل رسالة شفوية من رسول اللّٰه إلى زياد، تقول: إنّي رسول رسول اللّٰه إليك، وهو يقول لك: زوّج جويبراً ابنتك الذلفاء!
5 - وفي مشهد خامس يصل جويبر إلى بيت زياد بن لبيد - وهو لا يصدّق أنّ الأمر سوف يحصل - وقد وجد في البيت بعضاً من قوم زياد (الأنصار)، فاستأذن بالدخول
ص: 159
فأذن له، وبعد أن استقرّ به المجلس أفصح عن نفسه أنّه رسول رسول اللّٰه في حاجة، وخيّره بين ذكر الحاجة أمام قومه أو يكون الإعلان عن الحاجة سرّاً بينهما فقط، فاختار زياد الاُول، فأعلن جويبر عن حاجته، وهي التزوّج من ابنته الذلفاء بأمر رسول اللّٰه، وفوجئ زياد بهذه الحاجة قائلاً: إنّا لا نزوّج فتياتنا إلّاأكفّاءنا من الأنصار! وقال زياد لجويبر: انصرف حتّى ألقى رسول اللّٰه فأخبره بعذري في الامتناع عن التزويج! وبهذا نرى رواسب الجاهلية ومقاييسها لم تزل موجودة في ذهنية وتصرّف زياد بن لبيد.
6 - وفي المشهد السادس ينصرف جويبر وهو يقول: واللّٰه ما بهذا نزل القرآن، ولا بهذا ظهرت نبوّة محمّد! وتعود خائباً إلى رسول اللّٰه! فهو قد سمع مراراً وتكراراً من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم حديثه الشهير: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، ألّاتفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير»(1)، وجويبر يملك الدين والخلق، وهما أمران أساسيان في قبوله كزوج، وإن افتقد بعض الأُمور الثانوية، فلماذا يُرفض كطالب للزواج، ونبوّة محمّد ظهرت بالتيسير في الأُمور لا التعسير، وظهرت بالخلق العظيم، الذي كان يتّصف به ربّان السفينة وقائد المسيرة.
7 - في المشهد السابع نرى الفتاة المخطوبة المطلوبة (الذلفاء بنت زياد الأنصارية) وهي تسمع مقالة أبيها زياد لجويبر وهي في خدرها، فطلبت أباها على الفور، فدخل عليها، فقالت له مستنكرة: ما هذا الكلام الذي سمعتك تحاور به جويبراً؟! فأجابها بما كان! فقالت لأبيها: واللّٰه ما كان جويبر يكذب على رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، فابعث الآن رسولاً يردّ عليك جويبراً! فعاد جويبر، فأبقاه في البيت، وذهب زياد إلى رسول اللّٰه يستوضح منه الأمر، فكان جواب رسول اللّٰه مطابقاً تماماً لما قاله جويبر، أعاد زياد مقالته لجويبر على رسول اللّٰه قائلاً: ونحن لا نزوّج فتياتنا إلّاأكفّاءنا من الأنصار. تصدّى رسول
ص: 160
اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ وهذه الرؤية غير السليمة، فقال له النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: يا زياد، جويبر مؤمن، والمؤمن كفوٌ المؤمنة، والمسلم كفوٌ المسلمة، فزوّجه يا زياد، ولا ترغب عنه (أي لا تكره تزويجه)، وهنا نجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ناصحاً لزياد و «الدين النصيحة»(1)، ولم يكرهه على ذلك.
8 - في المشهد الثامن من هذه القصّة القصيرة الجميلة في كتاب الكافي يرجع زياد إلى بيته بعد ملاقاته لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم ومحاورته له، يعود ليقرّر تزويج ابنته الذلفاء برغبة وطوعية منه ومنها وأمام قومها، وامتثالاً لما أمر به رسول اللّٰه والتزاماً بنصيحته - وهو المغيّر والمصلح وهو المثل والقدوة - فيأخذ بيد جويبر، ويزوّجه على سنّة اللّٰه وسنّة رسول اللّٰه، ويجهّز ابنته الذلفاء، ويعدّوا لجويبر منزلاً مؤثّثاً بالفراش والمتاع، ويشتروا له ثوبين، ويدخلوا جويبراً على الذلفاء، ويتمّ تأسيس الشركة الإلهيّة المباركة بين مؤمنَين اثنين وعضوين في أُمّة محمّد، أُمّة الإسلام.
9 - في المشهد التاسع من مشاهد هذه القصّة المعبّرة نجد جويبراً - وقد عظمت في عينه النعمة التي أنعم اللّٰه بها عليه، من زوجة جميلة ومنزل مؤثّث ووساطة رسول اللّٰه، وما إلى ذلك - يمتنع من الاقتراب من زوجته ثلاثة أيّام قضاها في تلاوة كتاب اللّٰه والصلاة والدعاء وصيام النهار، حتّى إذا علم أبوها بذلك ذهب إلى رسول اللّٰه شارحاً الموقف! فيرسل عليه ويستوضح منه حقيقة الأمر، فيقول: إنّما فعلت ذلك شكراً للّٰه، ولكن من الآن، بعد تمام هذه الأيّام الثلاثة سأُرضيها وأُرضيهم. وينقل رسول اللّٰه لزياد هذا التأكيد من جويبر ويطمئنه على أنّه قادر على فعل ما يفعله الرجال بزوجاتهم!
10 - وفي هذا المشهد من مشاهد القصّة التي تحكي لنا أوضاع المجتمع في الزواج بين الجاهلية والإسلام يفي جويبر بوعده، ويعيش مع زوجته الأنصارية بتمام السعادة والصفاء والإسلام؛ لأنّهما كانا متوافرين على صفتي الزواج الأساسيتين،
ص: 161
وهما (الدين والخلق)، وفي ظلال الإسلام ورسول اللّٰه، وبالرغم من التفاوت الطبقي بين الزوج والزوجة، فالإسلام لا يعترف بالتمايز الطبقي وبالاختلاف في المكوّن القومي أو اللوني.
11 - وفي المحطّة الأخيرة والمشهد الأخير من حياة جويبر، كان على موعد مع الشهادة، وهي قمّة السعادة، وقد كان رسول اللّٰه يقول: «فوق كلّ برّ برّ، حتّى يُقتل الرجل في سبيل اللّٰه، فإذا قُتل في سبيل اللّٰه، فليس فوقه برّ»(1)، فقد خرج رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إلى غزوة، وخرج معه الزوج السعيد جويبر، فختم حياته بالشهادة في سبيل اللّٰه، ولوجه اللّٰه، وتحت قيادة رسول اللّٰه، فسلامٌ عليه يوم ولد ويوم عاش ويوم استشهد ويوم يُبعث حيّاً.
جاء رجل من الأنصار إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فقال: يا رسول اللّٰه، اتّفقت جنازة ومجلس عالم في وقتٍ واحد، فأيّهما أحبّ إليك أن أشهد؟
فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «إن كان للجنازة من يتبعها ويدفنها، فإنّ حضور مجلس عالم أفضل من حضور ألف جنازة، ومن عيادة ألف مريض، ومن قيام ألف ليلة، ومن قيام ألف يوم، ومن ألف درهم يتصدّق بها على المساكين، ومن ألف حجّة سوى الفريضة، ومن ألف غزوة سوى الواجبة تغزوها في سبيل اللّٰه بمالك ونفسك، فأين تقع هذه المشاهد من مشهد عالم ؟! أما علمت أنّ اللّٰه يُطاع بالعلم، ويُعبد بالعلم ؟! وخير الدنيا والآخرة مع العلم، وشرّ الدنيا والآخرة مع الجهل»(2).
عند قراءة هذه القصّة ذات المشهد الواحد والتي يستفتي فيها رجل من الأنصار رسول اللّٰه حول ما إذا تزاحم أمران، الأمر الاُول تشييع جنازة مسلم، أو حضور درس عند عالمٍ ربّاني، فأيّهما يُقدّم وأيّهما يُفضّل، وهذا السؤال يذكّرنا بحديثٍ لرسول اللّٰه يقول فيه: «العلم خزائن ومفتاحه السؤال»(3)، وهذا السؤال من الرجل الأنصاري أوجد
ص: 162
فرصة ليضع من وجّه إليه السؤال النقاط على الحروف في جوابه، حيث نجد في الجواب البون الشاسع البعيد بين قيمة ومنزلة ومكانة العلم العظيمة السامقة في منظومة المنهج الإلهي، بين تشييع الجنازة، إذا كان هناك من يتبعها ويدفنها. وليس هذا بغريب، فإنّ أوّل كلمة نزلت من السماء إلى الأرض في كتاب اللّٰه هي كلمة «اقرأ»، وكرّرت مرّتين، تأكيداً لأهمّية القراءة التي تعني العلم والتنمية العلمية التربوية: «اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ اَلْإِنْسٰانَ مِنْ عَلَقٍ * اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ اَلْأَكْرَمُ * اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ اَلْإِنْسٰانَ مٰا لَمْ يَعْلَمْ »(1).
كما أكّد رسول اللّٰه في كثير من أحاديثه على أهمّية العلم:
اطلب العلم من المهد إلى اللحد(2).
طلب العلم فريضة على كلّ مسلمٍ ومسلمة(3).
وقد جاء في كتاب منية المريد: إنّ رسول اللّٰه دخل ذات يوم مسجد المدينة فشاهد جماعتين من الناس، كانت الجماعة الاُولى منشغلة بالعبادة والذكر، والأُخرى بالتعليم والتعلّم، فألقى عليهما نظرة فرح واستبشار، وقال للذين كانوا برفقته مشيراً إلى الفئة الثانية - فئة التعليم والتعلّم -: ما أحسن ما يقوم به هؤلاء! ثمّ أضاف قائلاً: إنّما بُعثت للتعليم، ثمّ ذهب وجلس مع الجماعة الثانية»(4).
ووردت الأحاديث الكثار عن أئمّة الهدى:
في حديث:
من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معاً فعلية بالعلم(5).
ص: 163
و في حديث:
لو علم الناس ما في طلب العلم، لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج(1).
وأيضاً:
كفى بالعلم فخراً أن يدّعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذمّاً أن يبرأ منه صاحبه.
وجواب خاتم الأنبياء على سؤال الرجل الأنصاري نصّ آخر صريح يؤكّد منزلة العلم، حيث يقول:
... حضور مجلس عالم أفضل من حضور ألف جنازة.
ومن عيادة ألف مريض.
ومن قيام ألف ليلة.
ومن قيام ألف يوم.
ومن ألف درهم يتصدّق بها على المساكين.
ومن ألف حجّة سوى الفريضة.
ومن ألف غزوة سوى الواجبة تغزوها في سبيل اللّٰه بمالك ونفسك.
فأين تقع هذه المشاهد من مشهد عالم ؟!
أما علمت أنّ اللّٰه يُطاع بالعلم، ويُعبد بالعلم ؟!
وخير الدنيا والآخرة مع العلم، وشرّ الدنيا والآخرة مع الجهل.
كان صفوان الجمّال حاضراً في مجلس الإمام الصادق عليه السلام، إذ دخل على الإمام رجل من أهل مكّة يقال له ميمون، وشكا للإمام تعذّر الكراء عليه، فقال الإمام عليه السلام لصفوان:
قم وأعن أخاك على قضاء حاجته. فقام صفوان وذهب مع الرجل، فيسّر اللّٰه له كراه، ثمّ رجع صفوان إلى مجلس الإمام عليه السلام، فسأله الإمام عليه السلام: ما صنعت في حاجة أخيك ؟ قال:
قضاها اللّٰه.
ص: 164
فقال الإمام الصادق عليه السلام: أما أنّك إذا أعنت أخاك المسلم أحبّ إليّ من طواف أُسبوع بالبيت.
ثمّ أضاف: إنّ رجلاً أتى الإمام الحسن عليه السلام وقال: أعنّي على قضاء حاجة، فتنعّل الإمام وقام معه، فمرّا على الحسين عليه السلام وهو قائم يصلّي، فقال الإمام الحسن عليه السلام للرجل: أين كنت عن أبي عبد اللّٰه تستعينه على حاجتك ؟ قال: أردت أن أُعلمه بحاجتي فأخبرني بأنّه معتكف.
فقال الإمام عليه السلام: أما أنّه لو أعانك، كان خيراً له من اعتكافه شهراً.
في هذه القصّة نشاهد عدّة مشاهد وصوراً معبّرة وملفتة للنظر:
1 - المشهد الاُول نجد فيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام - في المدينة المنوّرة - وهو يحمل هموم المجتمع الكبير الذي ينتمي إليه، يحمل كذلك هموم أفراد وأشخاص هذا المجتمع، فهذا رجل من أهل مكّة، يقال له ميمون يشكو إليه تعذّر الأجرة عليه، فيكلّف الإمام أحد رجاله (صفوان) لقضاء حاجته عاجلاً وبدون تأجيل.
وقد وردت الروايات في أهمّية السعي في حوائج الإخوان.
فعن خاتم الأنبياء في حديثه المشهور:
خير الناس من نفع الناس(1).
وعنه صلى الله عليه و آله و سلم:
الساعي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، وقاضي حاجته كالمتشخّط بدمه يوم بدر وأُحد(2).
وعن الإمام أبي عبد اللّٰه الحسين عليه السلام:
اعلموا إنّ حوائج الناس إليكم من نعم اللّٰه عليكم(3).
وفي سيرة الإمام الحسن عليه السلام: إنّه كان قد خرج يطوف بالكعبة، فقام إليه رجل
ص: 165
فقال: يا أبا محمّد! اذهب معي في حاجتي إلى فلان. فترك عليه السلام الطواف وذهب معه.
لماذا ذهب ؟ خرج إليه رجل حاسد للرجل الذي ذهب معه، فقال: يا أبا محمّد! تركت الطواف وذهبت مع فلان إلى حاجة ؟! فقال له الإمام الحسن عليه السلام: وكيف لا أذهب معه ورسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قال: من ذهب في حاجة أخيه المسلم فقُضيت حاجته، كُتبت له حجّة وعمرة، وإن لم تُقض له كُتبت له عمرة؛ فقد اكتسبت حجّة وعمرة، ورجعت إلى طوافي»(1).
2 - المشهد الثاني في هذه القصّة هو متابعة الإمام الصادق عليه السلام لهذه المسألة، وعدم الاكتفاء بإسناد قضاء الحاجة إلى صفوان، وكفى اللّٰه المؤمنين القتال! إنّ الإمام هنا يعطينا درساً عملياً في ضرورة متابعة حاجات الناس والسؤال عن ذلك، فحينها يرجع صفوان المكلّف بقضاء حاجة أخيه (ميمون) إلى مجلس الإمام، يسأله الإمام: ما صنعت في حاجة أخيك ؟ فيقول له صفوان: قضاها اللّٰه، فيقول الصادق عليه السلام: أما أنّك إذا أعنت أخاك المسلم أحبّ إليَّ من طواف أُسبوع بالبيت.
3 - في المشهد الثالث من هذه القصّة النافعة، يضيف الإمام ما يؤكّد على أهمّية قضاء حوائج الإخوان، يضيف ذلك أمام صفوان وأمام الآخرين في مجلسه ليؤكّد هذه المسلكية الحميدة التي يحبّها رسول اللّٰه، فيقول: إنّ رجلاً أتى الإمام الحسن عليه السلام وقال: أعنّي على قضاء حاجة، فتنعّل الإمام وقام معه، فمرّا على الحسين 7 وهو قائم يصلّي، فقال الإمام الحسن عليه السلام للرجل: أين كنت عن أبي عبد اللّٰه - شقيق الحسن - تستعينه على حاجتك ؟ قال الرجل: أردت أن أعلمه بحاجتي فأخبرني بأنّه معتكف. فقال الإمام الحسن معلّقاً: أما أنّه لو أعانك، كان خيراً له من اعتكافه شهراً.
فهل نتأسّى بهؤلاء الأعاظم الذين عمرت بهم النفوس وتغيّرت وصلحت ؟
عند دراستنا للقصص والحوارات في كتاب الكافي خرجنا من دراستنا النقدية بما
ص: 166
يلي:
إنّ القصص لها أهمّيتها الفائقة المميّزة في التربية والتعليم والتوجيه وتغيير السلوك، وهي أفضل وسيلة في ذلك.
إنّ قصص الكافي - نظراً لأهمّيتها وخطورتها وضرورتها - جزء أساس من كتاب الكافي، وليست أمراً هامشياً ثانوياً، وهي - القصص - كذلك في أشقّاء الكافي من أُمّهات ومصادر الكتب، مثل البحار والتهذيب والاستبصار وكتاب من لا يحضره الفقيه.
إنّ هذه القصص متأثّرة إلى حدٍّ بعيد بقصص القرآن العظيم، ومنعكسة عنها، وأهمّ عنصر مشترك فيها هو التصوير في التعبير، والتأثير في الآخر، لخروج الكلمات من القلب والكلمة التي تخرج من القلب تدخل إلى القلب، بينما الكلمة التي تخرج من اللسان لا تتعدّى الأذان، والكلمات الخارجة من القلب أقدر على إيصال الفكرة وترسيخها، قياماً بمهمّة التغيير الذاتي، تغيير النفوس من أجل إحداث التغيير الخارجي على مختلف الصعد: «إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُغَيِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ »(1) ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام:
ميدانكم الاُول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم على غيرها أعجز، فجرّبوا معها الكفاح أوّلاً(2).
إنّ العنصر الأساس في قصص الكافي - كما في غيره من أُمّهات الكتب وفي مقدّمتها القرآن المجيد - هو العبرة والاعتبار: «لَقَدْ كٰانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ »(3) .
إنّ هذه القصص لا تحكي ما جرى في الزمان الماضي الغابر، ولا تنغلق عليه، وإنّما تنفتح على الحاضر والمستقبل، فهي تخترق الحواجز والحدود الزمانية والمكانية، لتبقى حاجة الأجيال المتعاقبة، ومنارات لها في دروب الحياة.
ص: 167
وتأسيساً على ما سبق في النقطة الخامسة، نلاحظ في القصص التي أوردناها أنّها جاءت لأغراض وأهداف متعدّدة، فقصّة تعالج تقاليد اجتماعية طبقية جاهلية في قصّة (جويبر والذلفاء)، حيث يقول زياد بن لبيد، حينما جاء بإيعاز من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يخطب ابنته الأنصارية الحسناء، يقول زياد لجويبر بعد أن عرض الموضوع: «إنّا لا نزوّج فتياتنا إلّاأكفّاءنا من الأنصار!»، وهو يستمهل جويبر حتّى يلتقي بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ليستوضح الأمر، فلمّا لقي رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم استبدل الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم مفهوم زياد بن لبيد الجاهلي بمفهوم إسلامي نبويّ آخر يقول: «المؤمن كفؤ المؤمنة»، وتمّ الزواج وفق هذا المقياس الإلهي الجديد.
وفي قصّة ثانية نلاحظ أنّها تعالج حالة نفسية، وهي الاعتماد على الغير في حلّ الأزمات الشخصية، بينما يصل في النهاية إلى الحقيقة، ألا وهي أنّ حلّ الأزمات ينبع من داخل النفس والقرار الذي يتّخذه الإنسان بنفسه والإرادة التي يتمتّع بها، وقد جاء في الحديث الشريف أنّ : «المعونة على قدر المؤونة».
وفي قصّة ثالثة نضع أيدينا على عبرة ودرس وغرض آخر، عندما يتمكّن مسلم حقيقي من تغيير شخص ذمّي فيتحوّل إلى مسلم في النهاية من خلال سلوك المسلم المثالي ودعوة الحال لا دعوة المقال واللسان، وهكذا تتعدّد الأغراض، لتصب جميعها في خدمة الإنسان وتغييره فكرياً وشعورياً وسلوكياً نحو الأفضل.
إنّ التعبير البلاغي - النبويّ أو الإمامي - يتناول القصص بريشة التصوير المبدعة، التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها، فتستحيل القصّة حادثاً يقع، أو مشهداً متحرّكاً يجري، لا قصّة تروى، ولا حادثاً قد مضى، وهذه ميزة فنّية مشتركة بين قصص القرآن وقصص الكافي، بفضل الأُسلوب التصويري في التعبير.
ص: 168
القرآن الكريم
1. الاختصاص، المنسوب إلى أبي عبد اللّٰه محمّد بن محمّد بن النعمان العُكبَري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت 413 ه)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، بيروت: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1414 ه.
2. أعيان الشيعة، محسن بن عبد الكريم الأمين الحسيني العاملي الشقرائي (ت 1371 ه)، إعداد: السيّد حسن الأمين، بيروت: دار التعارف، الطبعة الخامسة، 1403 ه.
3. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار عليهم السلام، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (ت 1110 ه)، تحقيق: دار إحياء التراث، بيروت: دار إحياء التراث، الطبعة الاُولى، 1412 ه.
4. تاريخ دمشق، علي بن الحسن بن هبة اللّٰه بن عساكر الدمشقي، تحقيق: محمّد باقر المحمودي.
5. التصوير الفنّي في القرآن، سيّد قطب بن إبراهيم (ت 1387 ه).
6. التفسير الأمثل، ناصر مَكارم الشيرازي وآخرون، طهران: دار الكتب الإسلامية.
7. تفسير القرطبيّ (الجامع لأحكام القرآن)، أبو عبد اللّٰه محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيّ (ت 671 ه)، تحقيق: محمّد عبد الرحمٰن المرعشلي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1405 ه.
8. ثورة الفقيه ودولته (قراءات في عالمية مدرسة الإمام الخميني قدس سره، مقالة بعنوان: الإمام الخميني ملهم الثوار وأُمثولة الأخلاق)، السيّد حسين الموسوي (أبو هشام).
ص: 169
9. جامع أحاديث الشيعة، السيّد البروجردي (1383 ه)، قمّ : المطبعة العلمية.
10. الخصائص الفاطمية، مولى باقر بن المولى إسماعيل الكجوري الطهراني الشهير بالواعظ (ت 1313 ه).
11. الخصال، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، قمّ : منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية.
12. ديوان أبي العتّاهية، أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان المعروف بأبي العتّاهية (ت 211 ه)، تحقيق: لويس شيخو، بيروت: دار صادر.
13. روضة الواعظين، محمّد بن الحسن بن علي الفتّال النيسابوري (ت 508 ه)، تحقيق:
محمّد مهدي الخرسان، قمّ : منشورات الشريف الرضي.
14. سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279 ه)، تحقيق: عبد الرحمٰن محمّد عثمان، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1403 ه.
15. سنن الدارمي، أبو محمّد عبد اللّٰه بن عبد الرحمٰن الدارمي (ت 255 ه)، تحقيق: مصطفى ديب البغا، بيروت: دار العلم.
16. السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي (ت 458 ه)، تحقيق: محمّد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الاُولى، 1414 ه.
17. شرح أُصول الكافي، صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي المعروف بملّا صدرا (ت 1050 ه)، تحقيق: محمّد خواجوي، طهران: مؤسّسة مطالعات وتحقيقات فرهنگي، الطبعة الاُولى، 1366 ش.
18. الفرج بعد الشدّة، أبو القاسم عليّ بن محمّد التنوخي (ت 384 ه)، بيروت: مؤسّسة النعمان، الطبعة الاُولى، 1410 ه.
19. فلسفة الصراع.
ص: 170
20. الكافي، أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329 ه)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، طهران: دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثانية، 1389 ه.
21. المجموع (شرح المهذّب)، الإمام أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي (ت 676 ه)، بيروت: دار الفكر.
22. مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، (ت 1320 ه)، قمّ : مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الاُولى، 1408 ه.
23. مسند أحمد، أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني (ت 241 ه)، بيروت: دار صادر.
24. مسند الإمام زيد (مسند زيد)، المنسوب إلى زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام (ت 122 ه)، بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، الطبعة الاُولى، 1966 م.
25. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي (ت 654 ه)، نسخة مخطوطة، قمّ : مكتبة آية اللّٰه المرعشي.
26. المعتبر في شرح المختصر، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن المحقّق الحلّي (ت 676 ه)، قمّ : مدرسة مؤسّسة سيّد الشهداء، الطبعة الاُولى، 1364 ش.
27. موسوعة ميزان الحكمة، محمّد الرَّيشَهري وآخرون، قمّ : دار الحديث، 1425 ه.
28. نهج البلاغة، ما اختاره أبو الحسن الشريف الرضي محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي من كلام الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام (ت 406 ه)، تحقيق: السيّد كاظم المحمّدي ومحمّد الدشتي، قمّ : انتشارات الإمام عليّ عليه السلام، الطبعة الثانية، 1369 ه.
29. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104 ه)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قمّ : مؤسّسة آل البيت، الطبعة الاُولى، 1409 ه.
ص: 171
ص: 172
سمات الشخصية المؤمنة وأنماطها في فكر الإمام عليّ عليه السلام في كتاب أُصول الكافي، دراسة على وفق منهج البحث العلمي الحديث
د. علي شاكر عبد الأئمّة الفتلاوي(1)
حسن شاكر الفتلاوي(2)
لعلّنا ندرك أنّ التقدّم العلمي في مجال البحث السيكولوجي مرهون إلى حدٍّ بعيد باعتماده وحدة أساسية تنطلق منها الدراسات النفسية وتتمحور حولها، وأنّ هذه الوحدة تتمثّل على نحوٍ مناسب في مفهوم الشخصية «Personality» ، ذلك التنظيم الديناميكي في نفس الفرد لتلك الاستعدادات والمنظومات النفسية والعقلية والبيولوجية التي تحدّد طريقته الخاصّة في التوافق مع البيئة والآخرين.
بمعنى أنّ الشخصية اصطلاح أو مفهوم يصف الفرد كلّاً موحّداً متكاملاً، وأنّ لدراسة الشخصية في علم النفس وظيفة تكاملية، فكما يذكر «جاردنر مورفي» أنّه «إذا رغب عالم النفس في أن يرى جميع العلاقات والروابط الداخلية داخل الكائن العضوي دفعة واحدة، وكذلك تسلسل القوانين التي تحكم هذه العلاقات، فلابدّ أن
ص: 173
يهتم ويعني بسيكولوجية الشخصية»(1).
ولعلّ ذلك يمكن أن يتجسّد جلياً عند تلسّنا السمات والعوامل التي تصوغ الشخصية الإنسانية، فالشخصية هي أُنموذج السمات التي تميّز الفرد، والسمة «Trati» هنا تعني أيّ خاصّية نفسية عند الشخص، بما في ذلك استعداداته لإدراك المواقف المختلفة على نحوٍ متشابه، وأن يستجيب بشكلٍ متّسق برغم المنبّهات المتغيّرة والظروف والقيم والقدرات والدوافع والدفاعات وجوانب المزاج والهوية والنمط الشخصي.
وبحسب مفهوم القياس النفسي فإنّ الشخصية هي ذلك النمط من الخصائص التي ينفرد بها الشخص، بما في ذلك موقعه على عدد كبير من متغيّرات السمات(2)والسمة عند كاتل (Cattel) هي وحدة بناء الشخصية، وهي عامل أو متغير (Factor) ، أيّ أنّها تجمّع من العوامل المراتبطة فيما بينها ولها مصادر مشتركة.(3)
وفي البحث الحالي نريد أن نقول بأنّ مفهوم الشخصية الإنسانية بشكل عامّ ومفهوم السمات (Traits) بشكلٍ خاصّ ، قد غاص في أعماقه باب مدينة العلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، سابراً غور مكنونات الشخصية الإنسانية بمحدّداتها ومنظومات بنائها ودوافعها ومحرّكاتها ونموّها أو تطوّرها، ذلك ما نلمسه واضحاً في ثنايا الإرث المعرفي ومعطيات الأدب النفسي الهائل الذي تركه الإمام عليّ عليه السلام، والذي لم يتمّ تناوله بالبحث الحالي محاولة ربّما تلتئم حوله محاولات أُخرى، لاستلهام وتشخيص الاُسس والمبادئ السليمة التي لعلّها تفصح عن الطريق إلى نظرية إسلامية في الشخصية الإنسانية بروح ومصطلحات المنهج العلمي الحديث، محاولين التركيز على منظور غاية في الأهمّية ضمن أدبيات علم النفس الحديث، هو
ص: 174
منظور (Traits Perspective) مدخلاً إلى ذلك الهدف.
1 - محاولة التأصيل مع غيره من البحوث والدراسات للبحث النفسي الإسلامي، نحو علم نفس إسلامي يزيل شيئاً من الاغتراب الذي يعانيه الباحث والدارس لعلوم النفس في مجتمعاتنا، كون أنّ أغلب علوم النفس السائدة الآن تحمل معطيات ومفاهيم ومصطلاحات لثقافات أُخرى لعلّها دخيلة أو بعيدة عن ثقافتنا العربية الإسلامية، وأنّ طرح دراسات منهجية أُولىٰ ترمي إلى استظهار ملامح نظرية الشخصية لدى الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ينسجم على الأقلّ مع اللّاوعي الجمعي العربي الإسلامي، وربما يحقّق ذلك التأصيل.
2 - المعارف والعلوم التي فاضت عن فكر الإمام عليّ عليه السلام يمكنها أن تسهم - إنّ نجحنا في تقديمها - في الردّ على من ينكرون على العرب والمسلمين أصالة التصدّي بالعلم والمعرفة لتفسير منظومات الإنسان المختلفة، وفهمها وإدراك قضايا الإنسان الأساسية.
3 - محاولة نشر الثقافة النفسية الإسلامية، بمنهجٍ علمي واقعي يتماشى مع معطيات وأدوات العصر الذي نعيشه، من أجل ثقافة تصدر عن ذات واعية مبدعة، فالثقافة تعبّر عموماً عن قدرة الشعوب على التعلّم ونقل المعارف من جيلٍ إلى جيل من خلال استخدام الأدوات واللغة والانّساق الفكرية المجرّدة.
يتحدّد البحث الحالي بتناول خطبة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الواردة في كتاب أُصول الكافي، المجلّد الثاني، تحت عنوان (باب علامات المؤمن وخصاله)، مادةً رئيسةً للبحث والدراسة.
ص: 175
والمبحث الثاني: الإطار النظري، في هذا المبحث الخاصّ بالمنهج النظري للبحث الحالي، يتمّ بعمق وتركيز تناول مفهوم سمات الشخصية الإنسانية وأنماطها، وعلى وفق الآتي:
جاء معنى السمة في المنجد في اللغة: «وسَمَه يَسمُهُ وسماً وسَمِة، كواه أو أثّرَ بسمة أو كي، جعل له علامة يُعرف بها، اتّسم: جعل لنفسه سمة يُعرف بها، والسمة العلامة، وجمعها سمات.(1)
السمة مفهوم ذو طبيعة مجرّدة، فإنّنا لا نلاحظ السمة بطريقة مباشرة، بل نلاحظ مؤشّرات وأفعال مجرّدة أو نعمّم على أساسها، فالسمة إذن مستنتجة من الملاحظات الفعلية للسلوك، أو من خلال اختبار أو مقياس، فالسمة إطار مرجعي ومبدأ لتنظيم بعض جوانب السلوك والتنبّؤ به، وهي مُستنتجة ممّا نلاحظه من عمومية السلوك البشري، والسمة هنا ليست أبداً علّة السلوك، بل مجرّد مفهوم يساعدنا على وصف ذلك السلوك.(2)
وتُعدّ السمات عند عددٍ من المنظّرين في هذا الميدان، الوحدة الأوّلية في بناء الشخصية، وهي التي تساعد على تفسير حالات الثبات التي نجدها في الشخصية الإنسانية.
وبالإمكان عدّ السمات على أنّها أُسلوبية (Stylistic) وديناميكية (Dynamic) ، ذات
ص: 176
فعّالية أو تغيّر مستمرّ، فالسمة الأُسلوبية تخبرنا كيف يسلك الفرد، والسمة الديناميكية تخبرنا لماذا يسلك الفرد بالطريقة التي يسلك بها، فالأُولى تعطي الأُسلوب، في حينٍ أنّ الثانية تعطي العوامل الدافعة.(1)
وقد وضع «البورت» صاحب نظرية في السمات معابير ثمانية لتحديد السمة، هي:
1 - إنّ للسمة أكثر من وجود أسمي، بمعنى أنّها عادات على مستوىً أكثر تعقيداً.
2 - إنّ السمة أكثر عمومية من العادة، عادتان أو أكثر تنتظمان وتتسقان معاً لتكوين سمة.
3 - إنّ وجود السمة يمكن أن يتحدّد عملياً أو أحصائياً، وهذا ما يتّضح من الاستجابات المتكرّرة للفرد في المواقف المختلفة، أو في المعالجة الإحصائية على نحو ما نجد في الدراسات العاملية عند آيزنك وكاتل وغيرهما.
4 - السمة دينامية، بمعنى أنّها تقوم بدور دافعي في كلّ سلوك.
5 - السمات ليست مستقلّة بعضها عن بعض، ولكنّها ترتبط عادةً فيما بينها.
6 - إنّ سمة الشخصية - إذا نظرنا إليها سيكولوجياً - قد لا يكون لها الدلالة الخلقية نفسها، فهي قد تتّفق أو لا تتّفق والمفهوم الاجتماعي المتعارف عليه لهذه السمة.
7 - إنّ الأفعال والعادات غير المتّسقة مع سمة ما، ليست دليلا على عدم وجود هذه السمة، فقد تظهر سمات متناقضة أحياناً لدى الفرد على نحو ما نجد في سمتي النظافة والإهمال.
8 - إنّ سمة ما قد ينظر إليها في ضوء الشخصية التي تحتويها أو في ضوء توزيعها بالنسبة للمجموع العام من الناس، أي أنّ السمات إمّا أن تكون فريدة أو تكون عامّة مشتركة.
ص: 177
يفترض منظور السمات أنّ السلوك الإنساني للفرد - من خلال تعرّضه لمواقف عديدة مختلفة وسلوكه ازاءها - إنّما يعكس السمات الشخصية لذلك الفرد. وبمعنى آخر فإنّ السلوك إنّما يشكّل عموماً عن طريق العوامل الداخلية والسمات، وليس عن طريق الضغوط والمواقف الخارجية.
ونتيجة لهذا الافتراض، فإنّ منظور السمات يعتقد أن الطريقة المناسبة لدراسة الشخصية وتحديد معالمها هي محاولة قياس السمات المتعدّدة التي يمتلكها - ويظهرها بعد ذلك - الأفراد، وليس بواسطة الاستدلال عن حاجاتهم ومخاوفهم اللّاشعورية.
وبمعنى آخر فإنّ الشخصية الإنسانية يمكن وصفها بدلالة العديد من السمات المختلفة التي يظهرها الفرد من خلال سلوكه، وأنّ هذا الافتراض قائم عند كلّ منظّري هذا الإتّجاه، فقد لمعت أسماء كثيرة في العمل أو المناداة بالتفسير السماتي للشخصية، إلّاأنّ أسماء ثلاثة كانت أكثر لمعاناً وجذباً من غيرها في هذا الميدان، هؤلاء الثلاثة هم « Gorden Allport جوردن البورت» و « Raymond Cattell رايموند كاتل» و « Hans Eysenck و هانز آيزنك».
بما أنّ السمة تعرَّف في معجم هاريمان بأنّها: «أىّ خاصّية فيزيقية أو سيكولوجية للفرد أو الجماعة... عامّة أو متفرّدة»، وحسب جيلفورد: «بأنّها أيّ جانب يمكن تمييزه وذو دوام نسبي، وعلى أساسه يختلف الفرد عن غيره»، فإنّ هنالك حتماً أنواع مختلفة للسمات يتّصف بها الأفراد والجماعات، وقد اختلفت أنواع السمات في طروحات المنظّرين وفرضياتهم، ويمكن لنا إيجاز هذه الأنواع:
ص: 178
أ. السمات المعرفية، أو القدرات وطريقة الاستجابة للموقف.
ب. السمات الدينامية، وتتّصل بإصدار الأفعال السلوكية، وهي التي تختصّ بالاتّجاهات العقلية أو بالدافعية والميول، كقولنا: شخص طموح، أو شغوف بالرياضة، أو له اتّجاه ضدّ السلطة، وهكذا.
ج. السمات المزاجية، وتختصّ بالإيقاع والشكل والمثابرة وغيرها، فقد يتّسم الفرد - مزاجياً - بالبطء أو المرح أو التهيّج أو الجرأة وغيرها.
لاشكّ أنّ كلّ إنسان يتشابه مع بقية الآدميين في جوانب معيّنة، وهذه السمات هي العامّة أو المشتركة، ولكنّه في الوقت نفسه لا يشبه أيّ واحد منهم في جوانب أُخرى، وهذه السمات الخاصّة أو الفريدة.
والسمات العامّة هي السمات المشتركة أو الشائعة بين عدد كبير من الأفراد في حضارة معيّنة، أمّا السمات الخاصّة أو الفريدة فهي تلك التي تخصّ فرداً ما بحيث لا يمكن أن نصف آخر بنفس الطريقة.
فالسطحية تلك السمات التي يمكن ملاحظتها مباشرةً وتظهر في العلاقات بين الأفراد، كما يتّضح من طريقة الشخص في إنجاز عمل ما، وفي الاستجابات على الاختبارات، وهي قريبة من مكان السطح في الشخصية، وهي أقلّ ثباتاً، وأقلّ أهمّيةً .
أمّا السمات الأساسية فهي التكوينات الحقيقية الكامنة خلف السمات السطحية، والتي تساعد على تحديد وتفسير السلوك الإنساني، وهي ثابتة وذات أهمّية بالغة.
ص: 179
تمثّل السمات أُحادية القطب بخطٍّ مستقيم يمتدّ من الصفر حتّى درجة كبيرة، كالسمات الجسمية (المورفولوجية والفسيولوجية) والقدرات، ويمتدّ المدى من عدم وجود السمة من النوع الذي يقاس (الصفر) حتّى أكبر قدر ممكن من هذه السمة.
صفر + \
سمة أحادية القطب
فتمتدّ من قطب إلى قطب مقابل خلال نقطة الصفر، والسمات المزاجية عادةً ثنائية القطب، إذ نتحدّث مثلاً عن المرح مقابل الاكتئاب، والسيطرة مقابل الخضوع، والهدوء مقابل العصبية. وتوجد نقطة الصفر في مكانٍ تتوازن فيه الصفتان بدرجة متساوية، بحيث لا نستطيع أن نصف الفرد بأنّ لديه غلبة لواحدة منهما أو الأُخرى.
+ \ -
1
س صفر ف
هي وضع وتصنيف الأفراد في قوالب وطرز معيّنة بناءً على نقاط التشابه والاختلاف بين شخصياتهم، وقد تعدّدت نظريات أنماط الشخصية، لكنّها اتّفقت على هدف التوصّل إلى قوانين تفسّر السلوك الإنساني وتساعد التنبّؤ بالسلوك المستقبلي للإنسان في ضوء المعطيات توفّرها النظرية.
ص: 180
إنّ بعض نظريات الأنماط تمتدّ إلى الآف السنين (الأمزجة الشخصية)، وبعضها صنّف الأنماط حسب الأنشطة الهرمونية (النمط الدَرقي، النمط الادريناليني، النمط الجنسي، النمط النخامي، النمط الثيومسي)، وبعضها الآخر صنف الأنماط على وفق البنية الجسمية (النمط الحشوي، الجسمي، المخّي) أو (المكتنز، الرياضي، الواهن، البنية)، ومن النظريات من صنّف الأنماط تصنيفاً اجتماعياً (النمط العملي، البوهيمي، المبتكر، الاقتصادي، الجمالي، الاجتماعي، السياسي، الديني)، ومنها من صنّف الأنماط تصنيفاً نفسياً (الانبساطي، الانطوائي، العصابي)، وغيرها من النظريات المعاصرة كنظرية «هولاند Holaned » الذي صنّف الأنماط إلى ستّد:
(الواقعي، التحليلي، الفنان، الاجتماعي، التجاري، التقليدي).
وقد توصّل بعض منظّري منهج السمات إلى أبعاد أو أنماط أُخرى ربّما أقلّ انتشاراً، لكن سلوكنا ينضوي عليها في بعض المواقف الخاصّة، وهي (المحافظة، الراديكالية، البساطة، التعقيد، الصلابة والمرونة).(1)
يستند البحث الحالي إلى أُسلوب تحليل المحتوى (Content analysis) كأداة وتقنية أساسية من تقنيات المنهج الوصفي في البحث العلمي، ويقصد به الأُسلوب الذي يهدف إلى الوصف الموضوعي المنظّم الكمّي للمحتوى الظاهر للاتّصال، وكذلك إلى تبيان الدوافع والأهداف التي يرمي إليها الكاتب أو المتحدّث من محتويات نتاجاته، وبناءً على أُسلوب البحث المستند إليه في هذه الدراسة، فقد جرى تحليل محتوى خطبة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام (في علامات المؤمن وخصاله)، وعلى وفق الخطوات الآتية:
ص: 181
1 - تمّ استخراج وتصنيف سمات الشخصية المؤمنة على وفق منظومات الشخصية الإنسانية الأساسية، التي على ضوئها تُبنى الشخصية وتتحرّك وتنمو، وتلك المنظومات هي:
أوّلاً: منظومة الشخصية العقلية والفكرية، وبناءً عليها استُخرج من خطبة الإمام علي عليه السلام سمات الشخصية المؤمنة العقلية والفكرية.
ثانياً: منظومة الشخصية الانفعالية والوجدانية أو المزاجية(1)، وبناءً عليها استخرج من خطبة الإمام عليّ عليه السلام، مجموعة سمات الشخصية المؤمنة الانفعالية.
ثالثاً: منظومة الشخصية الاجتماعية، وبناءً عليها أستُخرج من خطبة الإمام عليّ عليه السلام، سمات الشخصية المؤمنة الاجتماعية.
رابعاً: منظومة الشخصية النفسية، وبناءً عليها أستُخرج من خطبة الإمام عليّ عليه السلام، سمات الشخصية المؤمنة النفسية.
خامساً: منظومة الشخصية الأخلاقية، وعلى وفقها استُخرجت سمات الشخصية المؤمنة الأخلاقية.
سادساً: منظومة الشخصية العملية الاقتصادية، وعلى وفقها استُخرجت سمات الشخصية المؤمنة العملية والاقتصادية.
2 - تمّ إحصاء ما ورد في الخطبة من سمات للشخصية المؤمنة، فوجدنا أنّ
ص: 182
الإمام عليّ عليه السلام قد أورد ما مجموعه (220) سمة للشخصية المؤمنة، أخضعنا (162) سمة منها للدراسة والبحث لأسباب عدّة.
3 - فيما يلي عرضاً تفصيلياً بالسمات حسب منظومات الشخصية الإنسانية التي أوردناها، مع نسبها المئوية من مجموع السمات الكلّي.
أورد الإمام على عليه السلام في خطبته المشار إليها السمات العقلية والفكرية التالية للمؤمن: «الفطن، مغموم بفكره، استفهامه تَعلّم، مراجعته تَفهّم، كثيرٌ علمه، عالمٌ رصين، يحبّ في اللّٰه بفقهٍ وعلمٍ ، مذكّر للعالم، معلّم للجاهل، دقيق النظر، لا ينطق بغير صواب، كلامه حكمة، يمزج الحلم بالعلم، يمزج العقل بالصبر، محكماً أمره، يخالط الناس ليعلم، يسأل ليفهم».
ونقصد بالسمات العقلية، تلك السمات المعبّرة عن الاستعدادت والفعاليات الإدراكية العليا التي يتميّز بها الإنسان عن غيره من الكائنات سعةً وعمقاً، مثل عمليات الإدراك الحسّي - العمليات التي يتمّ بواسطتها تفسير المثيرات الخارجية والداخلية التي تنقلها الحواسّ المختلفة إلى الدماغ - والتفكير والتعلّم والمعرفة والتخيّل والتذكّر والذكاء والتصوّر، والتي تتعامل معها منظومات الشخصية بناءً على أوامر الجهاز العصبي المركزي للإنسان.
ولعلّ كثير من هذه السمات لها أُصول أو استعدادات وراثية أو بيولوجية واضحة.
ونلاحظ من مجموعة السمات العقلية والفكرية التي وردت في الخطبة، أنّ الإمام علي عليه السلام جمع السمات والعوامل المحيطة بفعاليات الإنسان الذهنية كلّها، من الفطنة إلى الاستفهام إلى المراجعة، إلى كثرة العلم والرصانة ودقّة النظر والنطق بالصواب، والاتّجاه نحو الحكمة، وقد ذكر من السمات العقلية ما عدده (18) سمعةً . والجدول (1) يوضّح عدد السمات العقلية ونسبتها المنوية من مجموع السمات الكلّي:
ص: 183
ت السمات العقلية والفكرية عددها نسبتها المئوية 1 الفطن، مغموم بفكره، استفهامه تعلّم، مراجعته تفهّم، كثيرٌ علمه، عالمٌ رصين، يحبّ في اللّٰه بفقهٍ وعلمٍ ، مذكّر للعالم، معلّم للجاهل، دقيق النظر، لا ينطق بغير صواب، كلامه حكمة، يمزج الحلم بالعلم، يمزج العقل بالصبر، محكما أمره، يخالط الناس ليعلم، يسأل ليفهم. 11/118
أورد الإمام علي عليه السلام عدداً من السمات الانفعالية والمزاجية للشخصية المؤمنة بلغ عددها (20) سمة، تتمثّلف ب «حزنه في قلبه، بشره في وجهه، لا حقود، لا حسود، لا سبّاب، طويل الغمّ ، بعيد الهمّ ، كثير الصمت، إن ضحك لم يخرق، وإن غضب لم ينزق، مسرور بفقره، ضحكه تبسّم، لا يخرق به فرح، لا يطيش به مرح، هشّاش بشّاش، لا بعبّاس، لا بجسّاس، بسّام، كظوماً غيظه».
و هنا لابدّ من الإشارة إلى أنّ جميع الوجدانات والانفعالات والحالات المزاجية الإنسانية قد احتوتها الخطبة هذه، ونعني بالوجدانات والحالات الانفعالية والمزاجية تلك الأساليب الفردية الخاصّة التي يعتمدها شخصٌ ما في معايشته وتفاعله مع الواقع، وأيضاً تكيّفه مع هذا الواقع، وصولاً لتحقيق حاجاته، وإرضاء دوافعه وطموحاته الشخصية، وذلك طبعاً بالتناسق مع المتطّلبات والقواعد الاجتماعية.
لذا نجد أنّ الإمام علي عليه السلام قد أماط اللثام عن وجدانات الشخصية المؤمنة العملية الظاهرية «ضحكه تبسّم، لا يخرق به فرح، إن غضب لم ينزق... إلخ، وكذا الوجدانات الباطنة الداخلية «خزنه في قلبه، لا حقود، لا حسود، كظوماً غيظه... إلخ»، مشيراً بذلك
ص: 184
إلى أنّ الوجدان والانفعال يقوم بوظيفته كنظام فرعي رئيس في الشخصية، ويؤدّي دوراً بارزاً في السلوك. وذلك ما نجده في الأدبيات المعاصرة لعلم النفس، مثلما يرى ذلك «تومكنس 1962 Tomkins »:
إنّ نظام الوجدان هو النظام الدافعي الأوّلي للشخصية(1).
ومن الملاحظ أنّ السمات الانفعالية جاءت أكثر بقليل من السمات العقلية الواردة في الخطبة هذه، والجدول (2) يوضح العدد والنسبة المئوية.
ت السمات الانفعالية والوجدانية و المزاجية عددها نسبتها المئوية 1 حزنه في قلبه، بشره في وجهه، لا حقود، لا حسود، لا سبّاب، طويل الغمّ ، بعيد الهمّ ، كثير الصمت، إن ضحك لم يخرق، وإن غضب لم ينزق، مسرور بفقره، ضحكه تبسّم، لا يخرق به فرح، لا يطيش به مرحٌ ، هشّاش بشّاش، لا بعبّاس، لا بجسّاس، بسّام، كظوماً غيظه 12/320
أورد الإمام علي عليه السلام، للسمات الاجتماعية في شخصية الفرد المؤمن، حيّزاً واسعاً، فقد ذكر (49) سمة، تتمثّل ب «الكيّس، لا عيّاب، لا مغتاب، يكره الرفعة، يشنأ السمعة، سهل الخليفة، ليّن العريكة، رصين الوفاء، قليل الأذى، لا متأفّك ولا متهتّك، لا عنف ولا صلفّ ، لا متكلّف ولا متعمّق، جميل المنازعة، كريم المراجعة، عدلٌ إن غضب،
ص: 185
رفيقٌ إن طلب، لا يتهوّر ولا يتجبّر، وثيق العهد، وفليّ العقد، لا يغلظ على من دونه، لا يخوض فيما لا يعنيه، محام عن المؤمنين، كهف للمسلمين، قوّال، عمّال، رفيقٌ بالخلق، عونٌ للضعيف، غوث للملهوف، يُقبل العثرة، يغفر الزلّة، لا يدع جنح حيف فيصلحهُ ، يقبل العذر، يُجمِل الذكر، يحسن بالناس الظنّ ، مجالس لأهل الفقر، مصادق لأهل الصدق، مؤازر لأهل الحقّ ، عونٌ للقريب، أبٌ لليتيم، بعلٌ للأرملة، حفيٌّ بأهل المسكنة، مشيهُ التواضع، لا يهجر أخاه، لا يمكر بأخيه، آمناً منه جاره، يخالط الناس ليعلم».
ولعلّ المتفحّص لما أورده الإمام عليه السلام، في صفات المؤمن وعلاماته الاجتماعية، يجد أنّ هنالك فكراً اجتماعياً غاية في الدقّة، لا يصدر ولا يتمّ إلّاعن ذهن فيلسوف خبير، يجمع بين تحليلٍ استقرائيّ للذات الاجتماعية وحركتها ومساراتها في آن معاً، ثمّ لا تجد إلّاأن تندهش من تلك اللوحة التركيبية والتفكيكية في آن معاً أيضاً.
فقد وقف الإمام عليه السلام كثيراً على سمات المؤمن الاجتماعية إيماناً منه، عالماً ومحلّلاً واعياً بخفايا الإنسان ودوافعه وحاجاته الاجتماعية، حتّى وضع (49) سمة للمؤمن حينما يمارس دوره في محيطه الاجتماعي في أدواره الاجتماعية المختلفة، خلال تفاعله الاجتماعي مع واقعه المعاش، لذا مرةً يبيّن دوره كفرد له وجه اجتماعي يريده الناس منه: «كيّس، قوّال، عمّال، مشيّة التواضع... إلخ»، ومرةً يبيّن دوره في مواقف التفاعل الاجتماعي مع الآخرين: «لا عنف، لا صلف، جميل المنازعة، كريم المراجعة، وثيق العهد»... إلخ، ومرّات أُخرى يعطيه أدواراً اجتماعية استثنائية أو مضافة: «أبٌ لليتيم، بعلٌ للأرملة، حفيٌّ بأهل المسكنة»... إلخ.
وقد أراد الإمام عليه السلام القول إنّ حاجات ودوافع وغرائز المؤمن الاجتماعية هي من يجعله في قمّة هرم السمات الإنسانية التي يرضاها اللّٰه - عزّوجلّ - من عباده.
والجدول (3) يوضّح عدد السمات الاجتماعية ونسبتها المئوية.
ص: 186
ت السمات الاجتماعية للمؤمن عددها نسبتها المئوية 1 الكيّس، لا عيّاب، لا مغتاب، يكره الرفعة، يشنأ السُّمْعَة، سهل الخليقة، ليّن العريكة، رصين الوفاء، قليل الأذى، لا متأفّك ولا متهتّك، لا عنف ولا صلفٌ ، لا متكلّف ولا متعمّق، جميل المنازعة، كريم المراجعة، عدلٌ أن غضب، رفيقٌ أن طلب، لا يتهوّر ولا يتجبّر، وثيق العهد، وفيّ العقد، لا يغلظ على من دونه، لا يخوض فيما لا يعنيه، محام عن المؤمنين، كهف للمسلمين، مَوّال، عَمّال، رفيقٌ بالخلق، عونٌ للضعيف، غوثٌ للملهوف، يُقيل العثرة، يغفر الزلّة، لا يدع جنح حيف فيصلحهُ ، يقبل العذر، يُجمِل الذكر، يحسن بالناس الظنّ ، مجالس لأهل الفقر، مصادق لأهل الصدق، مؤازراً لأهل الحقّ ، عونٌ للقريب، أبٌ لليتيم، بَعلٌ للأرملة، حفيٌّ بأهل المسكنة، مشيهُ التواضع، لا يهجر أخاه، لا يمكر بأخيه، آمناً منه جاره، يخالط الناس ليعلم. 30/249
شخّص الإمام علي عليه السلام السمات الأخلاقية للشخصية المؤمنة، وجعلها (20) سمة تتمثّل ب «زاجرٌ، عن كلّ فانٍ ، راضٍ عن اللّٰه - عزّوجلّ -، مخالفٌ لهواه، ناصرٌ للدين،
ص: 187
لا يصرف اللعب حكمه، لا بفحّاش، لا بطيّاش، تقيّ ، يقطع في اللّٰه بحزمٍ وعزم، كلّ سعي أخلص عنده من سعيه، كلّ نفسٌ أصلح عنده من نفسه، يحبّ في اللّٰه، لا ينتقم لنفسه بنفسه، لا يوالي في سخط ربّه، خاضعٌ لربّه بطاعته، راضٍ عنه في كلّ حالاته، نيّته خالصة، ناصحٌ في السرّ والعلانية، خاشعٌ قلبهُ ، ذاكرٌ ربّهُ ».
نلاحظ في هذه السمات أنّ الإمام علي عليه السلام تناول خصائص السلوك الخلقي والديني للمؤمن تناولاً معيارياً، بمعنى أنّ الشخصية المؤمنة لابدّ أن تسلك على وفق هذه الخصائص، وإلّا فهي بعيدة بدرجةٍ أو بأُخرى عن تلك الشخصية المؤمنة، والجدول رقم (4) يوضّح عدد هذه السمات ونسبتها المئوية.
جدول رقم (4) السمات الأخلاقية والدينية
ت السمات الأخلاقية والدينية عددها نسبتها المئوية 1 زاجرٌ عن كلّ فانٍ ، راضٍ عن اللّٰه عَزّ وجلَّ ، مخالف لهواه، ناصر للدين، لا يصرف اللعب حكمه، لا بفحّاش، لا بطيّاش، تقيّ ، يقطع في اللّٰه بحزم وعزم، كلّ سعي أخلص عنده من سعيه، كلّ نفسٌ أصلح عنده من نفسه، يحبّ في اللّٰه، لا ينتقم لنفسه بنفسه، لا يوالي في سخط ربّه، خاضعٌ لربّه بطاعته، راضٍ عنه في كلّ حالاته، نيّته خالصة، ناصحٌ في السرّ والعلانية، خاشعٌ قلبهُ ، ذاكرٌ ربّهُ . 12/320
ص: 188
أشار الإمام علي عليه السلام إلى مجموعة من السمات والخصائص، التي يجب أن تنطوي عليها بناءات النفس المؤمنة، ولعلّ هذه السمات حينما يطّلع عليها المراقب الماهر والباحث الفاحص ذو الاختصاص، يجدها قد عبّرت عن حاجات ودوافع وملكات النفس البشرية السامية في كلّ حين. بمعنى آخر أنّها فرضيات نظرية خالدة للبناءات والمرتكزات السليمة للشخصية الإنسانية.
وهذه السمات بلغ عددها (42) سمة، وهي: «حليم، خمول، وصول في غير عنف، بذول في غير سرف، لا يختال، لا بغدّار، كثير البلوى، قليل الشكوى، أمين، نقيّ ، زكي، رضي، يتّهم على العيب نفسه، لا يُتوقّع له بائقة، لا يُخاف له غائلة، عالم بعيبه، لا يثق بغير ربّه، غريب، وحيد، جريدُ (حزين) مرجو لكلّ كريهة، مأمول لكلّ شدّة، صليبُ ، عظيم الحذر، لا يبخل، وإن بُخل عليه صبر، عقل فاستحيى، سكوته فكرة، كلامه حكمة، لا يأسف على ما فاته، لا يحزن على ما أصابه، بعيدٌ كسله، دائمٌ نشاطه، قريبٌ أمله، قليلٌ زلله، متوّفعٌ لأجله، قانعةٌ نفسه، سهلٌ أمره، حزينٌ لذنبه، صافي خلقه، متينٌ صبره، أذلّ شيء نفساً، لا وثّاب».
ولعلّنا هنا نشير إلى أن الإمام أعطى مضامين تفصيلية هائلة، وربّما تامّة لمعنى المرتكزات النفسية سلوكاً وفعلاً واستجابة، والجدول (5) يوضّح عدد هذه السمات ونسبتها المئوية.
ص: 189
جدول رقم (5) السمات النفسية العامة
السمات النفسية العامة عددها نسبتها المئوية 1 حليم، خمول، وصول في غير عنف، بذول في غير سرف، لا يختال، لا بغدّار، كثير البلوى، قليل الشكوى، أمين، نقيّ ، زكي رضي، يتّهم على العيب نفسه، لا يُتوقّع له بائقة، لا يُخاف له غائلة، عالم بعيبه، لا يثقّ بغير ربّه، غريب، وحيد، جريدٌ (حزين) مرجو لكلّ كريهة، مأمول لكلّ شدة، صليبُ ، عظيم الحذر، لا يبخل وإن بُخل عليه صبر، عقل فاستحيى، سكوته فكرة، كلامه حكمة، لا يأسف على ما فاته، لا يحزن على ما أصابه، بعيدٌ كسله، دائمٌ نشاطه، قريبٌ أمله، قليلٌ زلله، متوقّعٌ لأجله، قانعةٌ نفسه، سهلٌ أمره، حزينٌ لذنبه، صافي خلفه، متينٌ صبره، أذلّ شيءٍ نفساً، لا وثّاب. 25/942
بذهنية العارف المطّلع على دقائق وتفاصيل النفس البشرية، كان الإمام عليه السلام بارعاً في سبر غور الشخصية الإنسانية، حتّى إنّه وضع سماتاً وخصالاً للمؤمن العملي المدّبر، ذلك الإنسان في أدواره الاقتصادية، لذا فإئّنا وجدنا (10) سمات تشير إلى
ص: 190
ذلك، وهي: «صبور شكور، عمّال، ساعٍ في الأرض، يجاهد في اللّٰه ليتّبع رضاه، لا يلبس إلّاالاقتصاد، لا يفشل في الشدّة، لا يبطر في الرخاء، تراه بعيداً كسله، دائماً نشاطه، يتّجر ليغنم»، إيماناً من الإمام عليه السلام، بأنّ المؤمن لا بدّ أن يلتفت إلى هذه الجوانب المهمّة من شخصية المؤمن خلال تفاصيل حياته التي يحياها، والجدول (6) يوضّح عدد السمات العملية والاقتصادية ونسبتها المئوية.
جدول رقم (6) السمات العملية والاقتصادية
ت السمات العملية و الاقتصادية عددها نسبتها المئوية 1 صبور شكور، عمّال، ساعٍ في الأرض، يجاهد في اللّٰه ليتبع رضاه، لا يلبس إلّا الاقتصاد، لا يفشل في الشدّة، لا يبطر في الرخاء، تراه بعيداً كسله، دائماً نشاطه، يتّجر ليغنم 6/110
جدول رقم (7) يوضّح السمات الشخصية
المؤمنة مرتّبة حسب عددها ونسبتها المئوية
ت نوع السمات عددها نسبتها المئوية 1 السمات الاجتماعية 30/2449 2 السمات النفسية العامّة 2642 3 السمات الانفعالية 12/320 4 السمات العقلية والفكرية 12/921 5 السمات الأخلاقية 12/320 6 السمات العملية والاقتصادية 6/110 المجموع الكلي 99/8162
ص: 191
خرج البحث الحالي بمجموعة من النتائج والاستنتاجات، أهمّها:
1 - حينما وضع الإمام علي عليه السلام، سمات وخصال للشخصية المؤمنة، لم يدع نشاطاً أو فعّالية إنسانية - خفيّة أم ظاهرة -، إلّاوأشار إليها وشخّصها، بأُسلوب العالم الخبير بخفايا النفس والذهن البشري.
2 - إنّ الإمام علي عليه السلام قد سبق الجميع من العلماء والمفكّرين والمنظّرين والمختصّين بهذا الشأن، لا سيّما أصحاب منظور السمات المعاصرين، عندما اعتمد السمات والخصائص مدخلاً ومنظوراً مهمّاً لوصف وتفسير ودراسة الشخصية الإنسانية.
3 - كذلك فقد سبق الآخرين في التنظير لأنماط وأبعاد الشخصية الإنسانية، عندما أفراد خصائص لنمط الشخصية المؤمنة وخصائص لنمط الشخصية غير المؤمنة، بطريقة منهجية علمية واعية، عكس المحاولات الأُولى البدائية المؤرّخ لا في علوم النفس (هيبوقراط وغيره)، القاصرة جدّاً عن روح العلم وثوابته.
4 - إنّ الإمام علي عليه السلام، أبان معايير السمات متضمّنة في العلاقات الداخلية والارتباطات الوثيقة بينها، معروضة بشكلٍ مرتّب ومنطقي في خطبته المشار إليها.
5 - إنّ ما احتوته خطبة الإمام علي عليه السلام (باب علامات المؤمن وخصاله) يمكن أن تكون رافداً ثرّاً ومصدرا علميّاً مهمّاً من مصادر الفرضيات العلمية والإيحاءات المنهجية في طريق فهم وتفسير الشخصية الإنسانية للباحثين وطلبة العلم المتخصّصين.
6 - لعلّ هذه الدراسة المنصبّة على سمات الشخصية المؤمنة، ترفد منظور السمات المعاصر بحقائق كثيرة عن عوامل وسمات لم تُدرس حتّى الآن، يمكن أن تكون مشروعات بحثية أصيلة للباحثين وطلبة الدراسات العليا في المستقبل.
ص: 192
القرآن الكريم
1. الأبعاد الأساسية للشخصية، محمّد أحمد عبد الخالق، دار المعرفة الجامعية، القاهرة.
2. أُصول الكافي، محمّد بن يعقوب الكليني، المجلّد الثاني، طهران: دار الأُسوة للطباعة والنشر.
3. سمات الشخصية لذوي التفكير الخرافي، رسالة ماجستير غير منشورة، حيدر فاضل حسن علي، كلّية الآداب، جامعة بغداد.
4. سيكولوجية الشخصية، محدّداتها، قياسها، نظرياتها، سيّد محمّد غنيم، القاهرة: دار النهضة العربية.
5. قلق الموت وعلاقته بسمات الشخصية، رسالة ماجستير غير منشورة، بيداء هادي عبّاس، كلّية الآداب / جامعة بغداد.
6. معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، أحمد زكي بدوي، بيروت: مكتبة لبنان.
7. المنجد في اللغة، محمّد معلوف، بيروت: دار القلم.
8. نمط الشخصية (لذوي قدرات الإدراك فوق الحسّي، رسالة ماجستير غير منشورة نعيم هادي حسين الخفاجي، كلّية الآداب، الجامعة المستنصرية.
ص: 193
ص: 194
صبيح نومان الخزاعي(1)
الحمد للّٰه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين المصطفى الأمين محمّد، وآله الطيّبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وبعد.
قد وقع اختياري لقصّة يوسف ودراستها في كتاب الكافي للشيخ الكليني؛ وذلك لأسباب، منها: لما في هذه القصّة من دروس وعبر شأنها شأن قصص القرآن الأُخر، وكان يوسف إذ ذاك غلاماً يافعاً، وكان من المخلصين، وكان من المحسنين، وقد أتاه اللّٰه حكماً وعلماً، وعلمه من تأويل الأحاديث، وقد اجتباه اللّٰه وأتمّ نعمته عليه وألحقه بالصالحين، وأثنى عليه بما أثنى على آل نوحٍ وإبراهيم عليهما السلام، وضيّ الطلعة، وأنّه أُنموذج الرجل الواعي الحصيف، ماتت أُمّه وتركته وأخاه بنيامين وهما بأمسّ الحاجة إلى قلبٍ رؤومٍ يعطف عليهما.
وقد قُسّم البحث إلى مبحثين:
ص: 195
الأوّل: وتضمّن أغراض وأبعاد القصص القرآنية، ومناهج واستعراض القصص القرآني، ومواصفات قصّة يوسف.
المبحث الثاني: فقد وقف على مشاهد قصّة يوسف في كتاب الكليني، ومن هذه المشاهد مشهد الرؤيا، ومشهد الإلقاء في غيابة الجبّ ، ومشهد عودة بنيامين لأخيه يوسف، ومشهد لقاء يوسف وإخوته وعتابه ما سلف منهم.
وقد رجع البحث إلى مصادر ومراجع قديمة وحديثة، منها قصص الأنبياء للراوندي وابن كثير والطباطبائي، وبحوث ورسائل ماجستير، أغنت البحث بمعلوماتها.
تمثّل القصص القرآني صورة متكاملة من النظم، كما أنّها تكشف في يسر وسهولة عن علوّ البلاغة القرآنية واقتدارها على تصريف الأحداث وامتلاك زمامها، وتحريكها بحسب مقتضيات الحال والمقام، وهي أفضل وسيلة للتربية والتهذيب، فعن طريق العرض القصصي لحوادث القصّة وأشخاصها تتفتّح أشواق النفس إلى متابعة هذا العرض، وإلى المشاركة الوجدانية في مواقف القصّة وأحداثها(1).
وغرض القصّة إثبات الوحي والرسالة، وبيان أنّ الدين كلّه من عند اللّٰه، من عهد نوح إلى عهد محمّد صلى الله عليه و آله، وأنّ المؤمنين كلّهم أُمّة واحدة، واللّٰه الواحد ربّ الجميع، وبيان أنّ الوسائل (الأنبياء عليهم السلام) في الدعوة موحّدة، وأنّ استقبال قومهم لهم متشابه، وأنّ الأصل مشترك بين دين محمّد ودين إبراهيم بصفةٍ خاصّة، ثمّ أديان بني إسرائيل بصفة عامّة، وإبراز أنّ هذا الاتّصال أشدّ من الاتّصال العامّ بين جميع الأديان، وتصديق التبشير والتحذير، وعرض أُنموذج واقع هذا التصديق، وبيان أنّ نعمة اللّٰه على أنبيائه
ص: 196
وأصفيائه تبنّيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان، وبيان قدرة اللّٰه على الخوارق، كقصّة خلق آدم، وقصّة مولد عيسى، وقصّة إبراهيم والطير(1).
وفضلا عن تميّز كلّ شخصية من الرسل بميزات خاصّة، فإن كان هناك تشابه فهو التشابه العامّ الرئيس بين مبادئ الرسالات وأهدافها، وما كانت تُقابَل به من المعارضين، فتشابهت المواقف أحيانا لذلك(2).
وتهيّئ آفاق القصص القرآني الرحبة أرضية خصبة لإدراك أُصول الدعوة الدينية، وفهم الظروف الصعبة التي واجهت حملة الرسالات الإلهيّة، ومن ثمّ يعود إلى عزيمة أقوى وقدرة أوسع لنشر الدين الإسلامي الحنيف.
وإلى جانب مهمّة القصص القرآني تتمتّع الموعظة والذكر بأثر حسّاس يتسامى إلى أهداف أصيلة، كالوعي والانتباه والتذكّر، وتعبّر القصّة عن ثلث القرآن الكريم، وتتّصف بالواقعية، إذ لها علاقة بواقع الإنسان وإعادة قراءة التاريخ الإنساني وما حدث في حياة الأُمم السالفة والرسالات الإلهيّة، والاستفادة منها في الوقت الحاضر، والاعتبار بها في الحياة ومجرياتها، والتطلّعات المستقبلية(3).
وينتزع موضوع القصّة الناجحة من أحداث الحياة، ثمّ يجري أشخاصها في هذا المجال، ويوضع كلّ واحد في المكان المناسب له، وأنّها من هذه الناحية أداة قويّة من أدوات التربية والإصلاح في يد المسلمين والمربّين، وهي وسيلة من الوسائل الفعّالة في تقرير الحقائق وتثبيتها في النفوس، وهو قصّ جادّ للعبرة والموعظة، وليس فيها مجال للتسلية واللّهو.
وعناصر القوّة في القصص القرآني مستمدّة من واقعية الموضوع وصدقه ودقّة عرضه، والعناية بإبراز الأحداث ذات الشأن في موضوع القصّة، دون التعرّض
ص: 197
للجزئيات التي يشير إليها واقع الحال، وتدلّ عليها دلالات ما قبلها وما بعدها من صور(1).
وتبقى الأهداف الأصلية للقصّة - فضلاً عن العبرة والموعظة - هي تصديق النبوّات والتثبيت وإقامة الحجّة والبرهان على صدق نبوّة محمّد صلى الله عليه و آله ومضمون رسالته(2).
وأمّا أبعاد دراسة القصص القرآني فهي: البعد الأدبي وتصوير الأحداث، وبعد سياقي مرتبط بأغراض القصّة، وبعد تاريخي والسنن التي يمكن استنتاجها من القصّة، أو المفاهيم الاجتماعية والأخلاقية التي يمكن استنباطها منها(3).
وبُعد اجتماعي يتمثّل في اتّخاذهم الأوثان محوراً للعلاقات الاجتماعية في الولاء والمودّة، بدل اللّٰه تعالى، مع أنّ المحور في الولاء والمودّة لا أصل له، بل سوف يتحوّل بعد ذلك إلى عداوة وبراءة بعضهم من بعض يوم القيامة، مضافاً إلى وجود الحالة المدنية في حياتهم الاجتماعية، كالبناء والأعمال، والأعمال اليدوية. وأمّا البُعد السياسي فهو الذي كان يتمثّل في وجود نظام للحكم يرأسه ملك قوانين(4).
وأمّا مناهج استعراض القصص القرآني، فمنها: المنهج التقليدي الذي سار عليه المفسّرون وذكر حوادثها، ومنهج تحليلي من حيث الهدف العامّ والخاصّ وأسباب التكرار والأُسلوب، ومنهج نظري وهو استخلاص النظرية العامّة في القصّة من خلال تحليل مفرداتها، والجمع بينها تنوير نظري متكامل.
ومنهج اجتماعي وهو تصوير الحركة التغيرية السياسية والاجتماعية التي يقوم بها، ومنهج تاريخي في عرض الأحداث التي ذكرتها القصّة مترتّبة بحسب تسلسلها
ص: 198
الزمني وكوقائع تاريخية(1).
تختلف سورة يوسف عن سواها من طوال السور، بأنّها تعالج موضوعاً واحداً فقط هو حياة يوسف، باستثناء بضع آيات في النهاية، لكنّها على صلة بالآيات الأُخر، وقد أعطى الرسول هذه السورة في مكّة لأوّل المؤمنين من يثرب؛ ليأخذوها معهم لدى عودتهم إلى مدينتهم(2).
وغرض السورة بيان ولاية اللّٰه لعبده الذي أخلص إيمانه له تعالى، يتولّى أمره فيربّيه أحسن تربية، فيورده مورد القرب ويسقيه من مشروعه الزلفي، فيخلصه لنفسه ويحيه حياة إلهيّة، وإن كانت الأسباب بالظاهرة أجمعت على هلاكه، ويرفعه وإن توافرت الحوادث على ضعته، وان دعت النوائب ورزايا الدهر إلى ذلّته وحطّ قدره(3).
ومن حيث الإنجاز والإطناب أن نبدأ قصّة يوسف تسير مفصّلة حتّى تنتهي، فما يقع له مع إخوته، وما يحدث له في مصر بعد شرائه وتربيته، ومراودة امرأة العزيز له، وسجنه، وتعبير رؤيا خادمَي الملك، ثمّ تعبيره رؤيا الملك وخروجه، وولايته على خزائن الأرض أو وزارتي (المالية والتموين)، ومجيء إخوته وعودتهم، ومجيء أخيه، وعودة إخوته لأبيهم بدونه، وكمال القصّة بقدوم أبيه وأهله... كلّها تفصّل تفصيلاً دقيقاً؛ لأنّ التفصيل مقصود أوّلاً لإثبات الوحي والرسالة، وثانياً لأنّ هذه التفصيلات قيمتها الدينية في القصّة(4).
وإنّ التناسق بين حلقة القصّة التي تعرض والسياق الذي تعرض فيه، هو الغرض
ص: 199
المقدّم، وهذا يتوفّر دائماً، ولا يخلّ بالسمة الفنّية إطلاقاً، ونجد قصصاً أُخر تعرض من حلقة متأخّرة نسبياً، فيوسف تبدأ قصّته صبيّاً، فمن هذه الحلقة يرى الرؤيا تؤثّر في مستقبله جميعاً(1).
وقصص القرآن الكريم قصص جادّ، ومساق للعبرة والموعظة، وليس فيها مجال للتسلية، وعناصر القوّة في القصص القرآني مستمدّة من واقعية الموضوع وصدقه ودقّة عرضه، والعناية بإبراز الأحداث ذات الشأن في موضوع القصّة، دون التعرّض للجزئيات التي يشير إليها واقع الحال، وتدّل عليها دلالات ما قبلها وما بعدها من صور(2).
وكان في قصّة يوسف توافق في الختام من نوع خاصّ يتّفق مع القصّة في الابتداء، فقد بدأت القصّة برؤيا يوسف فختمت هذه الرؤيا، وسجود إخوته له وأبويه، ثمّ بالمشهد الأخير: يوسف ينفض يديه من كلّ شيء(3) ويتوجّه إلى ربّه بهذا الدعاء الخالص المنيب: «رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ اَلْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ اَلْأَحٰادِيثِ فٰاطِرَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي اَلدُّنْيٰا وَ اَلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصّٰالِحِينَ »(4) .
ولقد كان القصص المألوف في الحياة العربية قبل القرآن قصصاً خيالياً خرافياً، يُساق للّهو، ويزجي هذه الحياة الجافية القاسية، إلّاالأوهام والخيالات، مركّباً تنتقل بهم اللحظات إلى عالم الأماني والأحلام، ثمّ يصحون بعدها كما يصحو النائم من حلمٍ لا يمسك منه بشيء، هكذا كان القصص العربي قبل القرآن، لا يستدعي العقل ولا يتّجه إليه، إلّاإذا كان كلّه تقريباً حديثاً جارياً على ألسنة الحيوان أو الجنّ ، وهذا من شأنه أن يدعو المرء إلى أن يلقاه في عقله من عقل، حتّى يمكن أن يستمع إليه، وتقبل
ص: 200
أذن ما فيه من شلحات ومفارقات... أمّا قصص القرآن، فقد جاء على غير هذا الضرب، إذ جاء معرضاً حياً للكثير من أحداث الحياة الماضية ووقائعها(1).
في يوم من الأيّام دعا علي بن الحسين عليه السلام مولاة له، فقال:
لا يقف على بابي سائل إلّاأطعمتموه؛ فإنّ اليوم يوم الجمعة، قلت: ليس كلّ سائل محقّ ، فقال: أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقّاً فلا نطعمه ونردّه فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله، إنّ يعقوب كان يذبح كلّ يوم كبشاً فيتصدّق منه ويأكل هو وعياله منه، وأنّ سائلاً مؤمناً صوّاماً قوّاماً محقّاً، له عند اللّٰه منزلة، كان مجتازاً غريباً، اعترّ بباب يعقوب عشية الجمعة عند أوان الإفطار، فهتف على بابه: اطعموا السائل الغريب الجائع من فضلكم، فلمّا يئس شكا جوعه إلى اللّٰه تعالى، وبات خاوياً وأصبح صائماً، وبات يعقوب وآله شباعاً وأصبحوا عندهم فضلة من طعام.
فأوحى اللّٰه تعالى إلى يعقوب صلوات اللّٰه عليه، استوجبت بلواي، أو ما علمت أنّ البلوى إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي ؟ وذلك حسن نظر منّي لأوليائي، استعدّوا لبلائي.
فقلت لعلي بن الحسين صلوات اللّٰه عليهما، متى رأى الرؤيا؟ قال: في تلك الليلة التي بات فيها يعقوب وآله شباعاً، وبات ذلك الغريب جائعاً، فلمّا قصّها على أبيه اغتمّ يعقوب لما سمع من يوسف مع ما أُوحي إليه أن استعدّ للبلاء، وكان أوّل بلوى نزلت بآل يعقوب الحسد ليوسف عليه السلام(2).
ولا شكّ أنّ قول علي بن الحسين عليه السلام: «فإنّ اليوم يوم الجمعة» فيه تأكيد على حرمة هذا اليوم، إذ فيه تجتمع أهل الإسلام في كلّ أُسبوع مرّة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنّه اليوم السادس من السنة التي خلق اللّٰه فيها السماوات
ص: 201
والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أُدخل الجنّة، وفيه أُخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل اللّٰه فيها خيراً إلّاأعطاه إيّاه، وفيه أكمل اللّٰه الخليقة(1)، كذلك أكّد الإمام عليه السلام على حرمة السائل وعدم ردّه، قوله تعالى: «وَ أَمَّا اَلسّٰائِلَ فَلاٰ تَنْهَرْ»(2) ، أي فلا تكن جبّاراً ولا متكبّراً، ولا فحّاشاً ولا فظّاً على الضعفاء من عباد اللّٰه(3).
هناك طريقة متبعة في القصص القرآني جميعه على وجه التقريب، هي تلك الفجوات بين مشهد ومشهد التي يتركها تقسيم المشاهد قصص المناظر، بحيث تترك بين مشهدين أو حلقتين فجوة يملؤها الخيال، ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد اللّاحق، فقصّة يوسف قد قسّمت على ثمانية وعشرين مشهداً(4)، ومن مشاهدها:
قد رأى يوسف عليه السلام - وهو صغير قبل أن يحتلم - كأنّ أحد عشر كوكباً - وهم إشارة إلى بقية إخوته - والشمس والقمر - وهما عبارة عن أبويه - قد سجدوا له، فهاله ذلك «إِذْ قٰالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يٰا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سٰاجِدِينَ »(5) .
وهكذا أراد اللّٰه سبحانه أن يتمّ على يوسف النبيّ نعمته بالعلم والحكم والعزّة
ص: 202
والملك، يرفع به قدر آل يعقوب، فبشّره وهو صغير بهذه الرؤيا، فذكر ذلك لأبيه، فوصّاه(1) فقال: «قٰالَ يٰا بُنَيَّ لاٰ تَقْصُصْ رُؤْيٰاكَ عَلىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ اَلشَّيْطٰانَ لِلْإِنْسٰانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ »(2) ، وهذا قول يعقوب ليوسف، لم يخبر إخوته حتّى لا يكيدونه، فكتم ذلك(3).
ولعلّ في البناء الفنّي لقصّة يوسف على الرؤى والأحلام، دليلاً على أنّ جانب العبرة هو ما يهدف إليه القصص القرآني، فيوسف لم يكن داعية كسائر الأنبياء يستخدم فنّ القول، وإنّما كانت دعوته أنّه كان ناطق صدق بالعمل، مصدّق للإيمان، يستأنس بها المؤمنون، ولا عجب أنّنا بآية من سورة أُخرى، نستشعر يوسف من خلالها نبيّاً، انعكست صورته في الذاكرة الجمعية(4)، ولكن قد ظهر يوسف عليه السلام ونشرها، وهكذا كان البلاء، فاللّٰه يفعل ما يريد، وهذا يقودنا إلى مشهد آخر هو:
ولحبّ يعقوب الشديد لابنه يوسف عليه السلام لمّا يشاهد فيه من الجمال البديع ويتفرّس فيه من صفاء السريرة، لا يفارقه ولا ساعة، فثقل ذلك على إخوته الكبار، واشتدّ حسدهم له، حتّى اجتمعوا وتآمروا في أمره، فمن مشير على قتله، ومن قائل:
«اِطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صٰالِحِينَ »(5) .
ولكن كان من بين الإخوة من هو أكثر ذكاءً وأرقّ عاطفةً ووجداناً؛ لأنّه لم يرضَ بقتل يوسف أو إرساله إلى البقاع البعيدة التي لا يخشى عليه من الهلاك فيها، فاقترح
ص: 203
عليهم اقتراحاً ثالثاً، وهو أن يُلقى في البئر بشكلٍ لا يصيبه مكروه؛ لتمرّ قافلة فتأخذه معها(1)، وهكذا: «قٰالَ قٰائِلٌ مِنْهُمْ لاٰ تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيٰابَتِ اَلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ اَلسَّيّٰارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فٰاعِلِينَ »(2) .
وغيابة الجبّ هي غورة، وما غاب عين الناظر أو أظلم، وأنّ غيابة الجبّ الذي غيّبت يوسف عليه السلام عن أبيه لم تستطع أن تغيّبه عن ذاكرته، فكان يوسف حاضراً في عقل أبيه وفكره، وكأنّه كان تغيّباً مادّياً (جسدياً) من جانب، وحضوراً متزايداً من جانبٍ آخر، وهكذا ظلّ شبح يوسف يقض مضاجع إخوته. وتغيّب يوسف كان نقلة هائلة غيّرت معالم حياته، ثمّ حياة أُسرته، ثمّ لتأسيس أُمّة تُدعى «بني إسرائيل» في المكان الجديد، لقد نقل الجبّ يوسف من حياة البداوة وقساوتها إلى عالم المدينة(3).
وهكذا أُلقي بيوسف عليه السلام في الجبّ وهو ابن تسع سنين، وكان بين منزل يعقوب وبين مصر مسيرة اثني عشر يوماً(4)، وكان الإلقاء في الجبّ كما هو واضح من قول إخوته «القوه» يوحي بذلك الخوف البدائي لدى الإنسان، وهو الخشية من السقوط من منحدر، وعملية الإلقاء هذه أو الجعل في غيابة الجبّ تعني الخشوع لقانون الثقل والجاذبية، والذي يشدّ الإنسان إلى الأرض إلى عمقها، إنّها تعني فيما تعنيه التغيّب ونزعة الإخفاء، إنّه البحث من لدن إخوة يوسف إلى وجود كاتم للأسرار ومغيّب للكائن بأقلّ نسبة من الخسائر(5).
ولا بدّ لكلّ همّ وغمّ من فرج، فعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمّار الدهّان، عن مسمع، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
ص: 204
لمّا طرح إخوة يوسف في الجبّ ، أتاه جبرئيل عليه السلام فدخل عليه، فقال: يا غلام، ما تصنع ها هنا؟ فقال: إخوتي ألقوني في الجبّ ، قال فتحبّ أن تخرج منه ؟ قال: ذاك إلى اللّٰه عزّ وجلّ ، إن شاء أخرجني. قال: فقال: إنّ اللّٰه تعالى يقول لك ادعني بهذا الدعاء حتّى أخرجك من الجبّ ، فقال له: ومالدعاء؟ فقال: قل اللّهمّ إنّي أسألك بأنّ لك الحمد لا إلٰه إلّاأنت المنّان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرم، أن تصلّي علي محمّد وآل محمّد وآل محمّد، وأن تجعل ممّا أنا فيه فرجاً ومخرجاً.
قال: ثمّ كان من قصّته ما ذكر اللّٰه في كتابه(1).
وحين رمى يوسف إخوتُهُ في الجبّ ، خلعوا عنه قميصه وتركوه عارياً، فنادى:
اتركوا لي قميصي لأغطّى به بدني إذا بقيت حيّاً، وليكون كفنى إذا متّ ، فقال له إخوته: اطلب من الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر الذين رأيتهم في منامك ليكونوا مؤنسيك في هذه البئر، ويكسوك ويلبسوك ثوباً على بدنك!(2).
قد بلغ حزن يعقوب على يوسف حزن سبعين ثكلى، ولمّا كان يوسف عليه السلام في السجن دخل عليه جبرئيل عليه السلام فقال: إنّ اللّٰه تعالى ابتلاك وابتلى أباك، وإنّ اللّٰه ينجيك من هذا السجن، فاسأل اللّٰه بحقّ محمّد وأهل بيته أن يخلّصك ممّا أنت فيه.
فقال يوسف: اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ محمّد وأهل بيته إلّاعجّلت فرجي وأرحتني ممّا أنا فيه.
قال جبرئيل عليه السلام: فابشر أيّها الصدّيق، فإنّ اللّٰه تعالى أرسلني إليك بالبشارة بأنّه يخرجك من السجن إلى ثلاثة أيّام، ويملّكك مصر وأهلها، تخدمك أشرافها، ويجمع إليك إخوتك وأباك، فابشر أيّها الصدّيق إنّك صفي اللّٰه وابن صفيّه.
فلم يلبث يوسف عليه السلام إلّاتلك الليلة حتّى رأى الملك رؤيا أفزعته، فذكروا له يوسف عليه السلام(3).
وهكذا كانت غيابة الجبّ مكان انطلاق يوسف عليه السلام إلى عالم الشهرة، وليتحقّق من
ص: 205
خلالها حلم الطفولة في أن يجد أبواه والأحد عشر كوكباً ساجدين، وأن يُمَكّن له في الأرض. وما كان ليوسف أن يصل إلى كلّ هذا دون أن تتجمّع الأحقاد والضغائن في قلوب إخوته فتلقي به في ذلك الجبّ المظلم(1).
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، قال:
قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: التقيّة من دين اللّٰه، قلت: من دين اللّٰه ؟ قال: أي واللّٰه من دين اللّٰه، ولقد قال يوسف عليه السلام: «أَيَّتُهَا اَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ »(2) ، واللّٰه ما كانوا سرقوا شيئاً(3).
ولمّا فقد يعقوب يوسف، اشتدّ حزنه وتغيّر حاله، وكان يمتار القمح من مصر لعياله في السنة مرّتين، في الشتاء والصيف، فإنّه بعث عدّة من ولده ببضاعة يسيرة مع رفقة خرجت، فلمّا دخلوا على يوسف عليه السلام، عرفهم ولم يعرفوه، فقال: هلمّوا بضاعتكم حتّى أبدأ بكم قبل الرفاق، وقال لفتيانه: عجّلوا لهؤلاء بالكيل وأوقروهم واجعلوا بضاعتهم في رحالهم إذا فرغتم(4).
ثمّ أخرجه إليهم وأمر فتيانه أن يأخذوا بضاعتهم ويعجلوا لهم الكيل، فإذا فرغوا جعلوا المكيال في رحل أخيه بنيامين، ففعلوا ذلك. وارتحل القوم مع الرفقة، فمضوا ولحقهم فتية يوسف(5): «أَيَّتُهَا اَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ » ، فلا ريب من أنّ يوسف عليه السلام لم يكذب قطّ، ولعلّ من أوجه ما قيل فيها: أي «لسارقون يوسف من أبيه»، «قٰالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مٰا ذٰا تَفْقِدُونَ * قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِكِ وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ * قٰالُوا تَاللّٰهِ
ص: 206
لَقَدْ عَلِمْتُمْ مٰا جِئْنٰا لِنُفْسِدَ فِي اَلْأَرْضِ وَ مٰا كُنّٰا سٰارِقِينَ * قٰالُوا فَمٰا جَزٰاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كٰاذِبِينَ * قٰالُوا جَزٰاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزٰاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِي اَلظّٰالِمِينَ * فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعٰاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اِسْتَخْرَجَهٰا مِنْ وِعٰاءِ أَخِيهِ » ، ثمّ أمر بالقبض عليه واسترقّه بذلك(1).
وهنا يُسدل الستار لنلتقي بهم في مشهدٍ آخر.
عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل السرّاج، عن بشير بن جعفر، عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
سمعته يقول: أتدري ما كان قميص يوسف عليه السلام ؟ قال: قلت: لا، قال: إنّ إبراهيم عليه السلام لمّا أُوقدت النار، أتاه جبرئيل عليه السلام بثوبٍ من ثياب الجنّة فألبسه فلم يضرّه معه حرٍّ ولا بردٍ، فلمّا حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة، وعلّقه إسحاق على يعقوب، فلمّا ولد يوسف علّقه عليه، فكان في عضده حتّى كان ما كان، فلمّا أخرجه يوسف بمصر من التميمة، وجد يعقوب ريحه، وهو قوله: «إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لاٰ أَنْ تُفَنِّدُونِ »(2) ، فهو ذلك القميص الذي أنزله اللّٰه من الجنّة.
قلت: جُعلت فداك، فإلى مَن صار ذلك القميص الذي أنزله ؟ قال: إلى أهله. ثمّ قال:
كلّ نبي ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى آل محمّد صلى الله عليه و آله(3).
وقوله تعالى: «وَ جٰاؤُ عَلىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ »(4) ، أي مكذوب مفتعل؛ لأنّهم عمدوا إلى سخلة ذبحوها، فأخذوا من دمها فوضعوه ليوهموه أنّه أكله الذئب، قالوا: ونسوا أن يخرقوه، وآفة الكذب النسيان! ولمّا ظهرت علائم الريبة لم يرج صنيعهم على
ص: 207
أبيهم، فإنّه كان يفهم عداوتهم له(1).
وهناك دلالات كثيرة لهذا القميص، فهو يوسف الحي، وهو يوسف الحاكم، وهو لقيا يوسف، وهو اختفاء شبح المجاعة، وهذا كلّه يزيد من سعة الصورة الدلالية لدى المتلقّي، والرقّة والحنان والرحمة في تصوير عواطف إنسانية بين أب وابنه(2).
وهو دلالة يوسف الحي (ريحه)، ويوسف الحاكم (إرسال القميص بيد إخوته إلى أبيه)، واختفاء شبح المجاعة (العودة إلى أهله وعدم تعرّضهم إلى مجاعات السنين السابقة).
عن علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن فضالة بن أيّوب، عن سدير الصيرفي، قال:
سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: إنّ في صاحب هذا الأمر شبهاً من يوسف عليه السلام، قال:
قلت له: كأنّك تذكر حياته أو غيبته ؟ قال: فقال لي: وما يُنكَر من ذلك هذه الأُمّةُ أشباه الخنازير، إنّ إخوة يوسف عليه السلام كانوا أسباطاً أولاد الأنبياء، تاجروا يوسفَ وبايعوه وخاطبوه، وهم إخوته وهو أخوهم، فلم يعرفوه حتّى قال: «أَنَا يُوسُفُ وَ هٰذٰا أَخِي»(3) ، فما تنكر هذه الأُمّة الملعونة أن يفعل اللّٰه عزّ وجلّ بحجّته في وقتٍ من الأوقات كما فعل بيوسف، إنّ يوسف عليه السلام كان إليه مُلك مصر، وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوماً، فلو أراد أن يُعلمه لقدر على ذلك، لقد سار يعقوب عليه السلام وولده عند البشارة تسعة أيّام من بيوتهم إلى مصر، فما تنكر هذه
ص: 208
الأُمّة أن يفعل اللّٰه عزّ وجلّ بحجّته كما فعل بيوسف أن يمشي في أسواقهم ويطأ بسطهم حتّى يأذن اللّٰه في ذلك له كما أذن ليوسف(1)«قٰالُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ »(2) .
قالوا وتعجّبوا كلّ العجب وقد تردّدوا إليه مراراً عديدة وهم لا يعرفون أنّه هو:
«أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ » ؟ فاجابهم: «أَنَا يُوسُفُ وَ هٰذٰا أَخِي» ؛ يعني أنا يوسف الذي صنعتم ما صنعتم، وسلف من أمركم فيه ما فرّطتم. وقوله: «وَ هٰذٰا أَخِي» تأكيد لما قال(3).
فكانوا كلّما أمعنوا النظر في وجه العزيز ودقّقوا ملامحه، لاحظوا الشبه الكبير بينه وبين أخيهم يوسف، لكنّهم في الوقت نفسه لم يتصوّروا أنّه يمكن أن يكون أخوهم يوسف قد ارتقى وصار عزيزاً لمصر، أين يوسف وأين الوزارة ؟! لكنّهم تجرّأوا أخيراً وسألوه مستفسرين: «أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ؟» .
كانت هذه الدقائق أصعب اللحظات على الإخوة، إذ لم يكونوا يعرفون إجابة العزيز وأنّه هل يرفع الستار ويظهر لهم حقيقته، أم أنّه سوف يعتقد بأنّهم مجانين إذا ظنّوا هذا الظنّ ، وكانت اللحظات تمرّ بسرعة والانتظار الطويل يثقل على قلوبهم فيزيد في قلقهم، وأظهر لهم حقيقة نفسه وقال: «أَنَا يُوسُفُ وَ هٰذٰا أَخِي» ، لكن لكي يشكر اللّٰه تعالى على ما أنعمه من هذه المواهب والنعم جميعاً، ولكي يُعلم إخوته درساً آخر من دروس المعرفة(4)، قال: «قَدْ مَنَّ اَللّٰهُ عَلَيْنٰا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِينَ »(5) .
ص: 209
الغرض من مشاهد هذه القصّة في كتاب الكافي الكليني، ليرى القارئ كيف أنّ الكفرة الذين لايؤمنون بالأنبياء مصيرهم النار، وهو امتحان وابتلاء للمؤمن في هذا الكتاب الموسوعي، وسمته البارزة فيه هي الحديث الشريف.
ويعدّ الكليني عارف بالأخبار، وأوثق الناس في الحديث، ومن فقهاء الشيعة، وقد ذكر الكليني نماذج من الأنبياء عليهم السلام للتحدّث عن قصصهم، وامتداداً لهذه القصص التي ذكرها هي قصّة يوسف التي كانت لها دلالات عظيمة، منها:
1 - توسّل الأنبياء الأُمم السابقة بآل محمّد عليهم السلام، ونجاته بهذه العترة الطيّبة عترة الرسول صلى الله عليه و آله وآل بيته، والنبيّ يوسف واحد من هؤلاء الذين استنجدوا بمحمّد وآله حين أُلقي في الجبّ عارياً.
2 - كلّ ما ورثه الأنبياء من علم أو غيره قد انتهى إلى آل محمّد.
3 - الشبه الكبير بين يوسف عليه السلام وغيبة صاحب الأمر (عج).
ص: 210
1. القرآن الكريم.
2. إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها، عبد الكريم الخطيب، مصر: دار الفكر العربي، الطبعة الاُولى، 1383 ه.
3. تاريخ القرآن، تيودور نولدكة، تعجيل فريد بريش شفالي، بيروت: دار نشر جورج المزميلو سهايم زوريخ، بإذن دار نشر ومكتبة ديتريش فيسبادن، الطبعة الاُولى، 2004.
4. التصوير الفنّي في القرآن، سيّد قطب، بيروت: مكتبة القرآن.
5. تفسير القرآن العظيم، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774 ه)، بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، 1405 ه.
6. دفاع عن الكافي دراسة نقدية مقارنة لأهمّ الطعون والشبهات المثارة حول كتاب الكافي، ثامر هاشم حبيب العميدي، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، الطبعة الاُولى، 1410 ه.
7. في القصص القرآني، أحمد الشايب.
8. قصص الأنبياء، أبو الحسين سعيد بن عبد اللّٰه الراوندي المعروف بقطب الدين الراوندي (ت 573 ه)، إعداد وتنظيم: حسين الحسيني، قمّ : مؤسّسة انتصارات محبّين، الطبعة الاُولى، 1426 ه.
9. قصص الأنبياء، محمّد حسين الطباطبائي (1402 ه)، إعداد وتحقيق: الشيخ قاسم الهاشمي، قمّ : مطبعة أُسوة نشر إمام المنتظر (عج)، الطبعة الاُولى، 1425 ه.
10. قصص القرآن مقتبس عن تفسير الأمثل لآية اللّٰه العظمى ناصر مكارم الشيرازي، إعداد وتنظيم: السيّد حسين الحسني، قم: مطبعة ثامن الأئمّة عليهم السلام الطبعة الرابعة، 1384 ه.
ص: 211
11. القصص القرآني، محمّد باقر الحكيم، دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الاُولى، 1419 ه.
12. الكافي، أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329 ه)، إيران: دار الأُسوة للطباعة والنشر، 1382 ه.
13. المكان في القصص القرآني (دراسة فنّية)، شاهين كاظم، جامعة القادسة، رسالة ماجستير، 2001 م.
14. الميزان في تفسير القرآن، محمّد حسين الطباطبائيّ (1402 ه)، بيروت: منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الاُولى، 1997 م.
ص: 212
الشيخ صفاء الدين الخزرجي
عُرفت شخصية ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني (المتوفّى 329 ه) بالحديث أكثر من اشتهارها بالفقه، وذلك من خلال مصنّفه الكبير الكافي الذي وضعه في الأُصول والفروع، حيث طغت سمعة هذا المصنَّف على سائر الجوانب العلمية الأُخرى في شخصية مؤلّفه، فقد عكف - رضوان اللّٰه عليه - مدّة ليست بالقصيرة على جمع أحاديثه من الأُصول المعتمدة مقدّماً من خلال هذا الجهد الاستثنائي الذي دام عشرين عاماً عطاءً علمياً كبيراً.
ويمكن أن يشار أيضاً إلى سبب آخر في ضمور البعد الفقهي في عطائه العلمي، ألا وهو عدم تصنيفه في هذا المجال؛ حيث لم يترك أثراً فقهياً في عداد مؤلّفاته الستّة التي كتبها.
ومن أجل ذلك فقد يقال - وكما هو المتبادر إلى الأذهان - باستبعاد هذا الجانب في حياته، وبالمآل تحجيم دوره في إطار دائرة الحديث فحسب، كما هو المشهور والمعروف عنه. وعليه فيكون الحديث عن فقاهته وفقهه تحميلاً وتمحّلاً في البحث لا يستمدّ أدلّته من مبرّرات حقيقية وواقعية.
إلّا أنّ ثمّة وجهة نظر أُخرى ترى أنّ ما كتبه الكليني في باب الفروع من الكافي، قد توفّر على خبرة وثروة علمية وفقهية لا يستهان بها إذا ما قورنت بخبرات الآخرين من
ص: 213
فقهاء عصره وأبناء طبقته، من أضراب علي بن بابويه وولده الصدوق، وممّا يعزّز ذلك تعاطي الفقهاء آراءه ونقلهم أقواله في بحوثهم، ممّا يعكس اهتمامهم بفقهه وآرائه، حتّى أنّهم يستظهرون من روايته للرواية أو عنونته للأبواب الإفتاء بذلك.
ووفقاً لهذه الرؤية، فإنّه يمكن اعتبار فروع الكافي أثراً فقهياً روائياً على غرار سائر مصادر الفقه الروائي الأُخرى، كالهداية والمقنع، وغيرها، بل أكثرها استيعاباً وتفصيلاً، وكفى مع حفظ الأسانيد.
ومن هنا يمكن النظر إلى فروع الكافي والتعامل معه من زاويتين: فقهية وروائية في آنٍ واحد، ولا شكّ فإنّ لهذه الرؤية أثرها الكبير في تغيير نمطية التعامل مع هذا الأثر وإصلاح النظرة الآحادية القائمة على البعد الواحد في شخصية مؤلّفه، كما أنّه لو قدّر لمؤلّفاته الأُخرى أن تبقى، لتجلّت أبعاد أُخرى لنا عن شخصيته وعطائه العلمي، حيث كتب في الرجال «كتاب الرجال»، وفي الكلام «الردّ على القرامطة»، وفي الشعر والأدب «ما قيل في الأئمّة من الشعر»، وكلّ ذلك يعدّ عوالم مجهولة في شخصية هذا الرجل.
ويأتي على رأس تلك الأبعاد المجهولة البعد الفقهي. وفي هذا المقال نسعى إلى تسليط الضوء على هذا البعد الهامّ من حياة هذا الفقيه، ودراسة وتحليل ما وصل إلينا من فقهه وآرائه، لعلّها تكون أساساً لدراسة أعمق وأشمل للباحثين في هذا المجال.
لا شك أنّ كتاب الكافي قد ملأ فراغاً مرجعياً كبيراً؛ إذ لم يكن إلى عصر مؤلّفه جامع للأُصول والفروع يرجع إليه في الفقه والحديث والكلام وغيرها من العلوم، وإنّما الذي كان - في الغالب - هو عبارة عن مجموعة من الأُصول والكتب المتفرّقة والمبثوثة بأيدي الرواة وحفظة الحديث من غير تنقية أو تبويب أو استيعاب، فقام الكليني - وقد كان خبيراً بالأخبار بصيراً بها ناقداً لها - بعملية جمع وضبط وفرز
ص: 214
وانتقاء للأحاديث من تلك الأُصول، ثمّ إفراغها ضمن تقسيم صناعي جامع ومبتكر لم يتّفق مثله لكتاب مثله.
وتظهر لنا جسامة الجهد الذي بذله الكليني في هذا السبيل إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار المدّة الزمنية التي استغرقها تأليف هذا الكتاب، حيث دامت عشرين عاماً، هذا مع ما كان عليه الكليني من خبرة وكفاءة عالية تؤهّله للقيام به في أقصر فرصة ممكنة، سيما مع رواج الحديث وكتبه وأُصوله آنذاك؛ إذ كان الحديث يشكّل الطابع العامّ واللغة المدرسية لأغلب العلوم، فليس أمام الباحث ثمّة صعوبة في تحصيل تلك المادّة، خصوصاً مع ملاحظة بيئة الكليني ببغداد أو الري، وما كانت تمثّله من مركزية وريادة على الصعيد العلمي، ممّا يعني توفّر جميع العوامل والدواعي لإنجاز أيّ عمل علمي من هذا القبيل.
إنّ ملاحظة جميع هذه العوامل والأوضاع منضمّة بعضها إلى بعض، تقودنا إلى القول بأنّ ما قام به الشيخ الكليني لم يكن عملاً فنّياً أو تجميعياً صرفاً - بالرغم من كونه مهمّة أعظم بها من مهمّة، سيما وهي الأُولى من نوعها - بل ينمّ ذلك ويكشف عن خبرة وجهد علمي كبيرين كانا الأساس في جمع أحاديث هذه الموسوعة وتبويبها وتنسيقها وانتقائها من الأُصول المعتمدة بإخراج الصحيح منها، كما أوضحه في مقدّمة الكتاب. وبعبارة ثانية: إنّ هذا العمل يعتبر عملاً اجتهادياً وخبروياً في فهم الأخبار وفقهها.
ومن هنا فقد احتلّ هذا المصدر المهمّ الصدارة والتقدّم منذ اليوم الأوّل لتأليفه، فقد ارتشف من معينه علماء هذه الأُمّة من فقهائها وأئمّة الحديث فيها من الطبقة الأُولى المعاصرة لزمن تأليفه، مذعنين بقدرة مؤلّفه وبراعته في هذا الفنّ ، مقدّرين له جهده في هذا الكتاب.
قال الرجالي القديم الشيخ النجاشي:
كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي - وهو مسجد نفطويه النحوي -
ص: 215
أقرأ القرآن على صاحب المسجد، وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب، حدّثكم محمّد بن يعقوب الكليني.
ورأيت أبا الحسن العقرائي يرويه عنه.
وروينا كتبه كلّها عن جماعة شيوخنا: محمّد بن محمّد، والحسين بن عبد اللّٰه، وأحمد بن علي بن نوح، عن أبي القاسم جعفر بن قُولَوَيه، عنه(1).
وهي شهادة تكشف - بحقّ - عن المرتبة الرفيعة لهذا المصنّف الفذّ، واهتمام الوسط العلمي به آنذاك، وروايته له إجازة وسماعاً.
وقد روى هذا الأثر الخالد رجالات الفقه والحديث الأوائل ممّن كان له الصدارة في الفتيا والحديث، كالشيخ المفيد، والسيّد المرتضى، والشيخ الطوسي، والصدوق، وابن قولويه، والنجاشي، والتلّعُكبَري، والزُّراري، وابن أبي رافع الصيمري، وأبي المفضّل الشيباني، وابن عبدون، وغيرهم.
وقد أطبقت كلمات الأعلام على تفضيله وترجيحه:
قال الشيخ المفيد:
هو من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة(2).
وقال الشهيد الثاني بأنّه:
لم يعمل الإمامية مثله(3).
وقال المجلسي الأوّل بأنّه:
أضبط الأُصول، وأحسن مؤلّفات الفرقة الناجية، وأعظمها(4).
وقد تفرّد هذا المصنَّف العظيم بمزايا قلّ نظيرها في غيره:
منها: قرب عهده بزمن النصّ ؛ حيث كان تأليفه في عصر الغيبة الصغرى
ص: 216
وعهد السفراء.
ومنها: إنّه مجموع من الأُصول المعتمدة والكتب المعوّل عليها عند الطائفة.
ومنها: الالتزام بنقل نصّ الحديث لا النقل بالمعنى.
ومنها: الالتزام بإيراد جميع سلسلة السند من المؤلّف إلى المعصوم عليه السلام متّصلاً، وقد يُحذف صدر السند، ولعلّه لنقله عن أصل المروي عنه من غير واسطة أو لحوالته على ما ذكره قريباً، وهذا في حكم المذكور(1).
ومنها: جامعيته لفصول المعرفة كافّة، من العقائد والأحكام والأخلاق، بعكس أقرانه الثلاثة التي اختصّت بالأحكام والفروع فحسب.
ومنها: حسن التبويب وحسن التعبير عن عناوين الأبواب وانطباقها على الروايات المنضوية تحتها.
ومن هنا فقد حظي هذا المصنّف بعناية الأعلام منذ القدم، فأولوه اهتماماً فائقاً، شرحاً وتعليقاً واختصاراً وترجمةً وتحقيقاً.
وقد عدّ بعض الباحثين من جملة شروحه الكثيرة اثني عشر شرحاً، ومن التعليقات عليه إحدى وعشرين تعليقة(2).
تنحصر دراسة هذا البعد في حدود القسم الثاني من كتاب الكافي، أي قسم الفروع؛ إذ لا سبيل لاستكشاف الملامح العامّة من فقهه وتسليط الضوء عليها غير ما بثّه من آراء واستدلالات وبيانات فقهية خلال بحوثه الروائية.
وقد أورد في هذا القسم من كتابه نحو عشرة آلاف حديث من أبواب الفقه كافّة، من الطهارة إلى الديات، مبوّباً هذه الأحاديث بتقسيم فنّي مبتكر ودقيق، خالٍ من
ص: 217
التكرار والتداخل والخلط. وقد ختم بعض الأبواب بالنوادر من الأخبار، سالكاً في بيان الأحاديث الفقهية مسلك أهل الحديث في إيراد الأخبار في كلّ مسألة وباب مع بيانٍ ما - إذا اقتضى الأمر ذلك - لموارد تعارض الأخبار، أو بيان رأيه وفتواه على ضوء الروايات التي ينقلها، أو ببحث فروع الباب ومسائله بحثاً فقهياً استدلالياً قبل إيراد الأخبار الواردة فيها، كما فعل ذلك في أوّل كتاب الإرث، أو بتلخيص عامّ لمضمون مجموعة من الأبواب وأحاديثها، كما فعل ذلك في باب السهو والشكّ في كتاب الصلاة.
كما ضمّن كتابه - تمشّياً مع طريقة الفقهاء في بحوثهم - استشهادات عديدة لكلمات وآراء من سبقه من الفقهاء من أصحاب الأئمّة عليهم السلام؛ من أمثال زُرارة بن أعيَن، ويونس بن عبد الرحمٰن، والفضل بن شاذان.
ومن أجل توضيح هذه الموارد نتوقّف عندها؛ لتسليط الضوء عليها وإيضاحها بشكل أكثر تفصيلاً:
قد ذكر الفقهاء أنّ الغسلة الثانية في الوضوء سنّة، بل ادُّعي الإجماع عليه. وذهب الشيخ الكليني قدس سره إلى أنّه لا يؤجر على الثانية، مستدلّاً على ذلك بقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام:
«ما كان وضوء علي عليه السلام إلّامرّة مرّة»، ولمّا كان هذا الحديث يحكي فعله عليه السلام، فهو من سنخ أحاديث الوضوءات البيانية التي قد يرد عليها أنّه عليه السلام قد اكتفى بالواجب من الغسل، فإنّ الشيخ الكليني - وكأنّه يجيب على هذا الإشكال المقدّر - ذكر أنّ الإمام - صلوات اللّٰه عليه - كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّٰه طاعة، أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه(1).
ثمّ إنّه تعرّض بعد ذلك للروايات المعارضة الدالّة على أنّ «الوضوء مرّتان»،
ص: 218
جامعاً بينهما بأنّ ذلك لمن لم يقنعه مرّة واستزاد.
فالملاحظ في هذه الممارسة الاجتهادية أنّه لم يقتصر فيها على إيراد الخبر إيراداً كما هو دأب المحدّثين، بل علّل ذلك مبيّناً الوجه في هذه العلّة، وهو الحديث المروي عنه عليه السلام من أنّه كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّٰه طاعة أخذ بأحوطهما، وهي التفاتة ظريفة في المقام، وبذلك فإنّه يجيب عن إشكال مطويّ ومقدّر. كما أنّه لم يقف عند أحد طرفي الأدلّة في المسألة، بل أورد الروايات المعارضة لها، ثمّ صار بصدد التوجيه والجمع بينهما.
أ. المشهور بين الفقهاء - بل هو موضع وفاق بينهم(1) - أنّ الجدّ وكذا الجدّة، لأبٍ كانا أم لأُمٍّ ، لا يرثان مع وجود الأبوين، فهما بمنزلة الأخ مع وجود الأبوين لا يرثان.
وقد عقد الشيخ الكليني باباً في إرث الجدّ أورد فيه ما يدلّ على أنّ الجدّ يقاسم الإخوة فهو بمنزلتهم، ثمّ أورد في باب إرث ابن الأخ والجدّ أخباراً تدلّ على أنّ لهما السدس طعمة، معقباً عليها بأنّ «هذا قد روي، وهي أخبار صحيحة».
ثمّ قال في مقام علاج التعارض ورفعه: «إلّاأنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ، وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ، يجوز أن تكون هذه أخباراً خاصّة، إلّاأنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أطعم الجدّ السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد، وليس هذا أيضاً ممّا يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة»(2).
فإنّ الملاحِظ لهذا النصّ يجده أنّه قد انطوى على عملية اجتهادية توازن بين كفّتي الروايات المتعارضة في مسألة إرث الجدّ لتحسم التنافي بينهما لصالح الأخبار التي
ص: 219
قام الإجماع على مدلولها، بمعنى عدم توريثه، ومن هنا فإنّ ما ورد في إطعامهما السدس محمول على الندب، قال في الجواهر: «المحكي عن الكليني رحمه الله بعد اعترافه بأنّ إجماع العصابة على تنزيل الجدّ منزلة الأخ المعلوم عدم مشاركته الأبوين، يقضي بإرادة الندب له»(1).
وكذا في مسألة وجود أب وجدّ ولم يكن له ولد، حيث ورد بعض الأخبار بإطعامه السدس في هذه الصورة خاصّة، فإنّه صرّح أيضاً بأن «ليس هذا أيضاً ممّا يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة»(2).
ب. المشهور المعروف بين الإمامية أنّ من شرائط القصد في السفر ألّايكون سفره أكثر من حضره، كالمكاري والملّاح وغيرهما، بل ادُّعي عليه الإجماع، إلّاما عن ظاهر العمّاني من وجوب القصد على كلّ مسافر.
ويدلّ على فتوى المشهور الروايات المستفيضة(3)، منها: ما رواه الكليني بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أربعة قد يجب عليهم التمام، في السفر كانوا أو الحضر: المكاري، والكريّ ، والراعي، والاشتقان؛ لأنّه عملهم(4).
وروى أيضاً في نفس الباب عن أحدهما عليهما السلام، قال:
ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمّال(5).
إلّا أنّه أخرج رواية أُخرى معارضة دلّت على أنّ «المكاري إذا جدّ به السير فليقصّر»(6).
وقد جمع بينهما: بأنّ ذلك إذا جدّ به السير فجعل المنزلين منزلاً واحداً. واختار
ص: 220
وجه الجمع هذا شيخ الطائفة في التهذيب، وتابعه عليه فقال:
الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله، قال: هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلاً، فيقصّر في الطريق ويتمّ في المنزل(1).
قال في الجواهر معلّقاً على هذا الوجه من الجمع:
ولعلّه لأنّه مقتضى الجمع بين الإطلاق والتقييد، ولما يلاقونه في الفرض من شدّة الجهد والتعب المناسبين لشرعية القصر، ولانصراف تلك الإطلاقات إلى السير المتعارف(2).
وقد عمل بذلك أيضاً من المتأخّرين جماعة، منهم صاحب المدارك والمنتقى، والمحدّث الكاشاني والفاضل الهندي، وصاحب الذخيرة والحدائق والمستند(3).
ج. روى في وقت التلبية للإحرام روايات عدّة، ثمّ جمع بينها:
الكليني عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
إذا صلّيت في مسجد الشجرة، فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثمّ قم فامشِ حتّى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه(4).
وروى أيضاً في نفس الباب عن عبد اللّٰه بن سنان، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام:
هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال: نعم، إنّما لبّى النبيّ صلى الله عليه و آله على البيداء؛ لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية، فأحبّ أن يعلّمهم كيف التلبية(5).
وأيضاً عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
ص: 221
قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالساً في دبر الصلاة ؟ قال: أيّ ذلك شاء صنع(1).
قال الكليني - في مقام الجمع بينها بالتخيير، وشاهد الجمع عنده هو خبر إسحاق بن عمّار الآنف -:
وهذا عندي من الأمر المتوسّع، إلّاأنّ الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على طرف البيداء، ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلّاوقد أظهر التلبية، وأوّل البيداء أوّل ميل يلقاك عن يسار الطريق(2).
وتبعه على هذا الوجه من الجمع الشيخ في الاستبصار(3)، والعلّامة المجلسي في شرحه(4).
من المسائل المهمّة في البحث الفقهي الوقوف على أقوال الآخرين وآرائهم، سيّما في المسائل الخلافية الحسّاسة؛ وذلك لتحصيل الوفاق والخلاف فيها. ومن هنا نجد الكليني رحمه الله قد اهتمّ بهذا الجانب في بعض المسائل الخلافية الهامّة في باب الإرث، فتارةً نجده يعنى بنقل أقوال فقهائنا السابقين كيونس والفضل وزرارة، وربما يستغرق نقله عنهم صفحات من كتابه، وقد ينحصر النقل عنهم به أحياناً، وتارةً ينقل آراء جمهور المسلمين ومواضع خلافهم أو وفاقهم معنا.
ولا شكّ فإنّ هذه العناية بنقل الأقوال والاهتمام بها، يؤكّد البعد الفقهي لفروع الكافي؛ لأنّ شأن المحدّث الاقتصار على نقل الرواية، ولا شأن له بالأقوال والآراء.
وفيما يلي نماذج من عنايته بنقل الأقوال، من الخاصّة أوّلاً ثمّ العامّة:
ص: 222
قال قدس سره:
قال زرارة: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجلٍ توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لأبيه وأُمّه، أو أُخته لأبيه وأُمّه، أو أُخته لأبيه، أو أخاه لأبيه، إنّهم يعطون الابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه وأُمّه، أو أُخته لأبيه وأُمّه، دون عَصَبة بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإخوة للأُمّ شيئاً... فقلت [الراوي] لزرارة: تقول هذا برأيك ؟ فقال: أنا أقول هذا برأيي ؟! إنّي إذاً لفاجر، أشهد أنّه الحقّ من اللّٰه ومن رسوله صلى الله عليه و آله و سلم(1).
قال قدس سره:
قال الفضل بن شاذان: فإن ترك جدّته أُمّ أبيه وعمّته وخالته، فالمال للجدّة. وجعل يونس المال بينهنّ . قال الفضل: غلط ها هنا [أي يونس] في موضعين: أحدهما أنّه جعل للخالة والعمّة مع الجدّة أُمّ الأب نصيباً. والثاني أنّه سوّى بين الجدّة والعمّة، والعمّة إنّما تتقرّب بالجدّة(2).
وقال الفضل أيضاً:
فإن ترك ابن ابن ابنٍ وجدّاً أبا الأب ؟ قال يونس: المال كلّه للجدّ. قال الفضل: غلط في ذلك؛ لأنّ الجدّ لا يرث مع الولد ولا مع ولد الولد، فالمال كلّه لابن الابن وإن سفل؛ لأنّه ولد، والجدّ إنّما هو كالأخ، ولا خلاف أنّ ابن ابن الابن أولى بالميراث من الأخ(3).
وأمّا ما نقله عن الجمهور وعنايته بمواضع إجماع المسلمين والخلاف معهم، فننقل هنا بعض النماذج منه أيضاً:
ص: 223
ميراث الولد
قال قدس سره:
الإجماع [قائم على] أنّ وُلد الولد يقومون مقام الولد، وكذلك وُلد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة، وهذا من أمر الولد مجمع عليه، ولا أعلم بين الأُمّة في ذلك اختلافاً(1).
ميراث البنتين
قال قدس سره:
وقد تكلّم الناس في أمر الابنتين، من أين جُعل لهما الثلثان، واللّٰه - جلّ وعزّ - إنّما جعل الثلثين لما فوق اثنتين ؟ فقال قوم: بإجماع، وقال قوم: قياساً؛ كما إن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلاً على أنّ لما فوق الواحدة الثلثين، وقال قوم بالتقليد والرواية. ولم يُصب واحد منهم الوجه في ذلك...(2).
ميراث الأزواج والإخوة والأخوات
قال قدس سره:
ثمّ ذكر [عزّوجلّ ] فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمّى لهم. وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع، فاختصرنا الكلام في ذلك.
ثمّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ فقال: «وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاٰلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ » يعني لأُمّ ، «فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي اَلثُّلُثِ »، وهذا فيه خلاف بين الأُمّة، وكلّ هذا «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ »(3) ، فالإخوة من الأُمّ لهم نصيبهم المُسمّى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأُمّ ، والإخوة والأخوات من الأُمّ لا يُزادون على
ص: 224
الثلث ولا ينقصون من السدس، والذكر والأُنثى فيه سواء، وهذا كلّه مجمع عليه، إلّا أن لا يحضر أحد غيرهم(1).
إنّ الملاحظ لهذه النماذج يلمس من خلالها سعة إطلاع المؤلّف، وعنايته بموارد الخلاف والوفاق في فقهنا وفقه الجمهور.
إنّ الملاحظ لمصنّفات القدماء يجد اهتماماً خاصّاً منهم ببعض الأبواب الفقهية، حيث كانت بعض مسائلها مدار البحث والخلاف بين الفريقين، وذلك نظير مسائل باب الوضوء والنكاح والطلاق والإرث. والسبب في ذلك هو أنّ مدارك تلك الأحكام والفروع هو القرآن الكريم، وهو مصدر مشترك بين الجميع قطعي الصدور عندهم، ومن هنا فإنّ الجميع يحاول التمسّك بآياته وتقريب الاستدلال بها على مقصوده.
ولذا نجد أنّ الشيخ الكليني قدس سره قد عدل عن طريقته التي سار عليها في مجمل بحوث كتابه بالاقتصار على إيراد الأخبار، حيث نجده يخوض غمار البحث الفقهي الاستدلالي الذي يستعرض الأدلّة ويدرسها، وربّما يطرح بعضها ويرفضها، كما هو شأن كلّ فقيه، وهذا ما نلاحظ نماذجه في بحث الوضوء وبعض مسائل الصلاة وباب الفيء والأنفال.
وأنصع صورة لبحوثه الاستدلالية هو بحث الإرث، حيث قام أوّلاً في أوّل كتاب الإرث ببيان الطبقات وتوضيحها، ثمّ قام في باب آخر ببيان الفرائض المكتوبة لهم في الكتاب شارحاً ذلك ببيان وافٍ على ضوء الآيات المبيّنة للفرائض والأسهم، مع استعراض للأقوال ومواطن الإجماع والخلاف في تلك المسائل، وطرح المناقشات التي يمكن أن ترد في البحث مجيباً عليها، ثمّ يشرع بعد ذلك بتبويب الأخبار المتعلّقة بمسائل كتاب الإرث، كلّ ذلك يضع الباحث أمام نموذج من نماذج البحث
ص: 225
الفقهي في كتاب الكافي، ليقف عند صورة تعكس مستوى البحث الفقهي لمؤلّفه الفقيه وهو يخرج عن منهجه الحديثي التقليدي الذي سار عليه في كتابه ليحرّر بحثاً فقهياً استدلالياً في فروع ومسائل شتّى.
يظهر للمتتبّع لتأريخ علم الأُصول أنّ التكوين الأوّل لهذا العلم قد بدأ - بشكلٍ رسمي ومقرّر - في القرنين الرابع والخامس. وهذا لا يلغي - بالطبع - الجهود العلمية الأُولى التي سبقت هذه الفترة والتي ظهرت في بعض مصنّفات أصحاب الأئمّة في هذا المجال؛ إذ إنّا نتكلّم عن الوجه الرسمي لهذا العلم كصناعة مقرّرة تمتلك مقوّماتها ومنهجها الخاصّ بها.
وقد عاصر فقيهنا الكليني بدايات تلك المرحلة التي أرسى قواعدها بعض معاصريه من فقهائنا العظام الذين افتقدنا آثارهم وعطاءهم العلمي، الأمر الذي أفقدنا امتلاك تصوّر كامل وجامع في هذا المجال.
والكليني بالرغم ممّا اشتهر وعُرف عنه من اهتمامه بأمر الحديث، فإنّ المتتبّع في مجموع آرائه وبحوثه الفقهية التي ضمّنها كتابه الروائي، يجد أنّ ثمّة مرتكزات ومنطلقات أُصولية للبحث الفقهي عند الكليني، نشير إليها لعلّها تكون ومضة في الكشف عن خلفيات البعد الفقهي عند هذا الفقيه:
يدور محور البحث الفقهي لدى الكليني على الأدلّة التالية: الكتاب، السنّة، الإجماع.
أمّا الدليل الأوّل فقد استند إليه في مجموعة من آرائه وبحوثه الاستدلالية، وهي كثيرة، ولكن نشير إلى موردين منها؛ لتميّزهما بطرافة الاستدلال ودقّة النظر لدى الكليني:
ص: 226
1 - قال في ميراث البنتين:
وقد تكلّم الناس في أمر البنتين من أين جعل لهما الثلثان، واللّٰه - جلّ وعزّ - إنّما جعل الثلثين لما فوق اثنتين ؟
فقال قوم: بإجماع، وقال قوم: قياساً؛ كما إن كان لواحدة النصف، كان ذلك دليلاً على أنّ لِما فوق الواحدة الثلثين. وقال قوم: بالتقليد والرواية. ولم يُصب واحد منهم الوجه في ذلك.
فقلنا: إنّ اللّٰه جعل حظّ الأُنثيين الثلثين، بقوله: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » ، وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتاً وابناً، فللذكر مثل حظّ الأُنثيين وهو الثلثان، فحظّ الأُنثيين الثلثان، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأُنثيين بالثلثين، وهذا بيان قد جهله كلّهم، والحمد للّٰه كثيراً(1).
نلاحظ في هذا النصّ أنّه بعد تقرير الأدلّة والأقوال الأُخرى، يرجع بالمسألة إلى الآية الكريمة التي هي الأصل في الحكم، حيث اشتملت على حكمين: أحدهما - وهو الأساس فيها - فريضة الذكر إذا اجتمع مع أُنثى، والآخر - وهو الذي غفل عنه القوم - هو فريضة الأُنثيين، وهو الثلثان، فتكون الآية قد ذكرت حكم الأُنثيين في طول بيان حكم الذكر.
فأغنى ذلك عن الاستدلال بالقياس أو الإجماع أو الرواية، والمراد بها رواية جابر عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في ابنتي سعد بن ربيعة الذي قُتل في يوم أُحد، فأعطاهما الثلثين بعد أن تريّث، حتّى نزل قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » .
فنلاحظ في هذه اللفتة الدقيقة من الشيخ الكليني تركيزاً على القرآن واستظهاراً لنكتة ظريفة في الآية، ولعلّه أوّل من تنبّه لذلك، كما يشعر به قوله: «وهذا بيان قد جهله كلّهم، والحمد للّٰه كثيراً».
كما أنّي لم أعثر على مصرّح به كالشيخ في الخلاف والمبسوط والصدوق في الفقيه.
ص: 227
نعم، أشار المتأخّرون إلى أصل النكتة مع تطويرٍ لها. قال في المسالك في المسألة:
«والمحقّقون على أنّ ذلك مستفاد من قوله تعالى: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » ، فإنّه يدلّ على أنّ حكم الأُنثيين حكم الذكر، وذلك لا يكون في حال الاجتماع؛ لأنّ غاية ما يكون لهما معه النصف إذا لم يكن معه ذكر غيره، فيكون ذلك في حالة الانفراد»(1).
2 - قال في حكم الفيء والأنفال:
إنّ اللّٰه تبارك وتعالى جعل الدنيا كلّها بأسرها لخليفته، حيث يقول للملائكة: «إِنِّي جٰاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً » ، فكانت الدنيا بأسرها لآدم، وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه، فما غلب عليه أعداؤهم ثمّ رجع إليهم بحربٍ أو غلبةٍ سُمّي فيئاً، وهو أن يفيء إليهم بغلبةٍ وحربٍ ، وكان حكمه فيه ما قال اللّٰه تعالى: «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ »(2) .
ففي هذه الممارسة الاجتهادية نجد تركيزاً على استحضار النصّ القرآني. وقد استفاد - كما يبدو - من الآية الاُولى نكتة ظريفة لإثبات ملكية الخليفة للأرض، وذلك من نفس لفظ «الخليفة» في الأرض، فإنّ الأرض لمّا كانت في الأصل للّٰه تعالى، فإنّ مقتضى استخلافه فيها أن تكون له، وإلّا فلا وجه للاستدلال بالآية بغير ذلك، واللّٰه العالم.
والدليل الثاني يمثّل المحور الأساس في كتابه.
وأمّا الإجماع فقد ارتكن إليه في مواضع من كتاب الإرث، مرتئياً حجّيته بالرغم من عدم الوقوف على منشأ الحجّية والاعتبار لديه. وإليك بعض النماذج والتطبيقات في هذا المجال:
أ. قال في كتاب الإرث - في بيان الفرائض -:
ص: 228
إنّ اللّٰه - جلّ ذكره - جعل المال كلّه للولد في كتابه، ثمّ أدخل عليهم بعد الأبوين والزوجين، فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة؛ وذلك أنّه عزّوجلّ قال:
«يُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ »(1) ، فأجمعت الأُمّة على أنّ اللّٰه أراد بهذا القول الميراث، فصار المال كلّه بهذا القول للولد(2).
فإنّ المتأمّل في هذا النّص يلاحظ كيف أنّه حكّم الإجماع في فهم النّص، وهي ملاحظة جديرة بالاهتمام، حيث تلفتنا إلى دور الإجماع في تبيين النصّ وتفسيره.
ب. وقال أيضاً في وجوه الفرائض:
إنّ اللّٰه جعل الفرائض على أربعة أصناف، وجعل مخارجها من ستّة أسهم، فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقرّبون لا بغيرهم، ولا يسقطون من الميراث أبداً، ولا يرث معهم أحد غيرهم إلّاالزوج والزوجة؛ فإن حضر كلّهم قُسّم المال بينهم على ما سمّى اللّٰه عزّوجلّ ، وإن حضر بعضهم فكذلك، وإن لم يحضر منهم إلّاواحد فالمال كلّه له. ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرّب بنفسه وإنّما يتقرّب بغيره، إلّاما خصّ اللّٰه به من طريق الإجماع أنّ ولد الولد يقومون مقام الولد، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة. وهذا من أمر الولد مجمع عليه، ولا أعلم بين الأُمّة في ذلك اختلافاً(3).
وهنا نلاحظ أيضاً دور الإجماع في استثناء إرث ولد الولد من الحكم المذكور.
ج. وقال أيضاً بعد أن أورد ما يدلّ على إرث الجدّ والجدّة السدس طعمة المخالف للمجمع عليه من أنّهما لا يرثان ذلك مع وجود الأبوين:
هذا - أي ما يدلّ على إطعامهم السدس - قد روي، وهي أخبار صحيحة، إلّاأنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ.
ثمّ قال في مقام توجيه هذه الأخبار:
ص: 229
وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ، يجوز أن تكون هذه أخبار خاصّة.
ثمّ قال:
إلّا أنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أطعم الجدّ السدس مع الأب، ولم يعطه مع الولد، وليس هذا ممّا يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة(1).
وهذا النصّ يثير اهتمام الباحث كثيراً ويستوقفه طويلاً؛ إذ كيف لفقيهٍ محدّثٍ يعرض عن النصوص الصحيحة الصريحة ويحملها على أنّها أخبار خاصّة ليراعي إجماع العصابة ويحذر مخالفتهم! إلّاأن يريد بما أجمعوا عليه من الأخبار، فيكون حينئذٍ قد جعل الإجماع عاضداً ومرجّحاً لأحد شقّي التعارض بين هذه الأخبار، وسيأتي الكلام عن ذلك عند التعرّض لبحث المرجّحات في حالات التعارض.
وهذا ما يظهر منه في مواطن عديدة في كتابه، سيّما بالنسبة لظواهر القرآن، حيث استشهد بالنصوص القرآنية معوّلاً على ظاهرها مضافاً إلى نصّها.
وهي من المسائل التي احتدم الكلام فيها عند الأقدمين من فقهائنا، فذهب البعض إلى منعها وعدم العمل بها، بل إلى استحالتها، والحجّة عندهم خصوص الخبر المتواتر، فيما ذهب الآخرون إلى حجّية أخبار الآحاد واعتبارها. وممّن ذهب إلى هذا الرأي فقيهنا المترجم، حيث أفتى في عدّة مواضع من كتابه بمضمون أخبار الآحاد، كما سنقف على ذلك عند التعرّض للمجموع من فقهه وفتاواه.
ص: 230
وهو من أهمّ مسائل علم الأُصول وأجلّها؛ لكثرة ابتلاء الفقيه بها في مقام البحث والاستنباط، ويُرجع في مثل هذه الحالات عادةً إلى المرجّحات، وقسّمها الأُصوليون إلى المرجّحات السندية والمرجّحات الدلالية.
وقد أشار الشيخ الكليني إلى القسم الثاني منها في مقدّمة كتابه عند الإشارة إلى اختلاف الأخبار وتعارضها، منبّهاً على عدم إمكان الجمع بينها بالرأي دون الرجوع إلى الموازين التي أقامها الأئمّة عليهم السلام في مثل هذه الحالات. وهذه الموازين بحسب ما حدّدها هي:
أ. الموافقة للكتاب.
ب. مخالفة الجمهور.
ج. الأخذ بالخبر المجمع عليه.
قال قدس سره:
إنّه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلّاعلى ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: اعرضوها على كتاب اللّٰه؛ فما وافق كتاب اللّٰه عزّوجلّ فخذوه، وما خالف كتاب اللّٰه فردّوه، وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم، فإنّ الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه.
ثمّ يشير إلى موارد تطبيق هذه القواعد وقلّة الاطّلاع على تشخيصها والوقوف عليها، فيقول:
ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّاأقلّة، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السلام، وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السلام: بأيّ ما أخذتم من باب التسليم وسعكم(1).
ولم نعثر - في حدود التتبّع - على تطبيق لهذه المرجّحات سوى المرجّح الثالثّ
ص: 231
في مسائل باب الإرث. وهذا لا ينفي - بالطبع - إعمالها جميعاً بحسب الواقع عند اختياره للأخبار التي أوردها في كتابه. قال الحجّة السيّد حسن الصدر في عداد مميزات كتاب الكافي:
ومنها: إنّه غالباً لا يورد الأخبار المعارضة، بل يقتصر على ما يدلّ على الباب الذي عنونه، وربما دلّ ذلك على ترجيحه لما ذكر على ما لم يذكر(1).
وعلى أيّ حال، فإنّ من تطبيقات المرجّح الثالث ما أشرنا إليه سابقاً في مسألة إرث الجدّ مع وجود الأبوين، حيث قدّم الروايات الدالّة على منعه من الإرث على روايات الطعمة سدساً؛ لقيام الإجماع على الأُولى مع صحّة الروايات الثانية.
المصطلحات
لم يستخدم المصطلح الأُصولي في بحثه كثيراً، ولعلّ لذلك مبرّراته التاريخية والموضوعية الواضحة، ولكن لا يعني هذا خلوّ البحث من تداول المصطلح، كما نلاحظ استخدامه لمصطلح «الإجماع» و «التعارض» و «الأمر المتوسّع»، ويعني به الواجب الموسّع في بحث التلبية من كتاب الحجّ ، وسيأتي موضعه.
استدلّ ثقة الإسلام لرأيه بقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في جواب عبد الكريم عندما سأله عن الوضوء، فأجابه: «ما كان وضوء علي عليه السلام إلّامرّة مرّة»(1).
قال قدس سره: «هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة»، معلّلاً ذلك بأنّه - صلوات اللّٰه عليه - كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّٰه طاعة، أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه، حاملاً ما دلّ على أنّ الوضوء مرّتان على من استزاد ولم يقنع بالواحدة.
واستدلّ للمشهور - مضافاً إلى الإجماع - ببعض الصحاح، كصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام، قال:
الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه(2).
ونحوه صحيح معاوية بن وهب(3)، وصحيح صفوان بن يحيى(4) عنه عليه السلام، قال:
فرض اللّٰه الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله للناس اثنتين اثنتين.
ولكن ثمّة رواية أُخرى لم ينقلها في الكافي كان ينبغي نقلها وهو في مقام الاستنباط؛ حيث روى عمرو بن أبي المقدام:
إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله توضّأ اثنتين اثنتين.
وهي بلا شكّ تعارض ما رواه عن علي عليه السلام من أنّ وضوءه كان مرّة مرّة. وقد جمع بينهما بعض الفقهاء(5) بما روي عنه أيضاً من «إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله وضع الثانية لضعف الناس»،
ص: 233
وكأنّ وجهه أنّ الاثنتين سنّة؛ لئلّا يكون قد قصّر المتوضّئ في المرّة فتأتي الثانية على تقصيره، وهم عليهم السلام منزّهون عن احتمال ذلك، فيكون الاستحباب بالنسبة إلى غيرهم.
ووجه الجمع بينهما: هو أنّ ما دلّ على أنّ وضوءه كان مرّة مرّة، يدلّ على أنّ عادته كانت المرّة؛ لكون الثانية مستحبّة بالنسبة إلى غيره، إلّاأنّه اتّفق له فعلها يوماً من الأيّام لغرض من الأغراض الصحيحة، كعدم تنفّر الناس عنها بتركها من جهته، أو نحو ذلك من الأغراض، فتكون مستحبّة بالنسبة إليه بالعارض.
2 - القول بوجوب غسل الجمعة، حيث عقد باباً أسماه «وجوب الغسل يوم الجمعة»، وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضاً الصدوقان(1)، والمشهور بل الإجماع على استحبابه(2). ومن قال باستحبابه حمل لفظ الوجوب في عباراتهم وفي الأخبار الواردة فيه على تأكّد الاستحباب؛ لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح، بل الظاهر من الأخبار خلافه. ومن قال بالوجوب يحمل السنّة على مقابل الفرض، أي ما ثبت وجوبه بالسنّة لا بالقرآن، وهذا يظهر أيضاً من الأخبار(3).
قال في الجواهر:
في صريح الغنية وموضعين من الخلاف الإجماع عليه أي الاستحباب، بل في أحدهما نسبة القول بالوجوب إلى أهل الظاهر داوود وغيره.
نعم، إنّما عُرف ذلك من المصنّف والعلّامة ومن تأخّر عنهما، فنسبوا القول بالوجوب إلى الصدوقين، حيث قالا: وغسل الجمعة سنّة واجبة، فلا تدعه، كما عن الرسالة والمقنع، ونحوه الفقيه والهداية، لكن مع ذكر رواية الرخصة في تركه للنساء في السفر لقلّة الماء، بل والكليني حيث عقد في الكافي باباً لوجوب ذلك، مع احتمال إرادة السنّة الأكيدة اللّازمة كالأخبار، كما يومئ إليه أنّه وقع ما يقرب من ذلك ممّن علم أنّ مذهبه الندب، مضافاً إلى ما عرفته سابقاً؛ إذ المتقدّمون بعضهم أعرف بلسان بعض. ويزيده تأييداً بل يعيّنه، ما حكي عن ظاهر الصدوق في الأمالي من القول بالاستحباب مع نسبته له إلى الإمامية. ولا ريب أنّ الكليني ووالده من أجلّاء
ص: 234
الإمامية، مع أنّهما عنده بمكانة عظيمة جدّاً سيما والده، بل والكليني أيضاً؛ لأنّه أُستاذه، هذا على أنّ قولهما: «سنّة واجبة» إن حمل فيه لفظ السنّة على حقيقته في زمانهما ونحوه من الاستحباب، كانت عبارتهما أظهر في نفي الوجوب.
وكيف كان فالمختار الأوّل، وعليه استقرّ المذهب؛ للأصل والإجماع المحكي بل المحصّل، والسيرة المستمرّة المستقيمة في سائر الأعصار والأمصار(1).
ويمكن الاستشهاد لإرادة الوجوب حقيقةً في كلام الكليني، بعدم إيراده خبراً واحداً، ممّا يدلّ على استحبابه ونفي الوجوب عنه، كما في صحيح ابن يقطين:
سأل أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، فقال: سنّة وليست فريضة(2).
بناءً على إرادة الاستحباب بها، لا ما ثبت بالسنّة في مقابل ما ثبت بالقرآن.
3 - ذهب قدس سره إلى عدم وجوب سجدتي السهو فيما لو سلّم سهواً بعد الأُولتين، والمشهور وجوبهما، بل ادُّعي عليه الإجماع.
وقد يستظهر الخلاف في المسألة أيضاً من جماعة، كالعمّاني والشيخ المفيد وعلم الهدى وابن حمزة وسلّار، حيث ذكروا الكلام ناسياً من غير ذكر السلام(3)، ونقل التصريح به عن علي بن بابويه وولده في المقنع(4).
وقد حاول بعض الفقهاء توجيه كلامهم وإخراجه عن دائرة الخلاف، بحمل الكلام الوارد في كلماتهم على ما يشمل التسليم في غير محلّه؛ لأنّه من الكلام أيضاً، وهو محتمل كلام الشيخ الصدوق في بعض نسخ المقنع، فيكون مراده من الكلام الأعمّ (5).
ص: 235
وحينئذٍ ينحصر الخلاف - ظاهراً - في كلام الكليني، أو هو ووالد الصدوق، حيث لم ينصّ عليه ولا على الكلام، وذلك لتصريح الكليني بنفيه، قال في عداد المواضع التي لا يجب فيها سجود السهو:
والذي يسلّم في الركعتين الأُولتين ثمّ يذكر فيتمّ قبل أن يتكلّم، فلا سهو عليه(1).
وهو صريح في سقوط سجدتي السهو فيه.
والظاهر أنّه استند في ذلك إلى ما رواه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قضية ذي الشمالين التي حكمت سجود السهو لمكان الكلام بعد السلام، لا لصرف وقوع السلام في غير موضعه(2).
4 - قال قدس سره:
إن شكّ [المصلّي] وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع، فليركع حتّى يكون على يقين من ركوعه، فإن ركع ثمّ ذكر أنّه كان قد ركع، فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع، فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع، فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأنّه قد زاد في صلاته ركعة(3).
وكأنّ الركن عنده يتحقّق بالركوع ورفع الرأس منه معاً، لا بالركوع حسب لتتحقّق بذلك الزيادة الركنية.
وقد وافقه على هذا الرأي السيّد المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس وابنا حمزة وزهرة، وأكثر المتأخّرين - بل قيل: إنّ عليه الفتوى - على خلاف ذلك، حيث أفتوا ببطلان الصلاة؛ لمكان زيادة الركن حتّى لو لم يرفع رأسه من الركوع(4).
ص: 236
ولم يستدلّ الشيخ الكليني وتابعوه لهذا الرأي بروايةٍ مكتفين بإيراد الفتوى حسب.
وقد استدلّ الشهيد لهم:
بأنّ ما صدر من المكلّف من حالة الركوع وإن كان بصورة الركوع ومنوياً به الركوع، إلّا أنّه في الحقيقة ليس بركوع؛ لتبيّن خلافه، والهوي إلى السجود واجب، فيتأدّى الهوي إلى السجود به فلا تتحقّق الزيادة، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع فإنّ الزيادة متحقّقة حينئذٍ؛ لافتقاره إلى هويّ إلى السجود(1).
5 - قال قدس سره:
إن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين، فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأنّه قد زاد في صلاته سجدة(2).
والمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً - كما في الجواهر - عدم بطلان الصلاة بذلك؛ لما دلّ على عدم بطلانها بزيادة السجدة، كخبر منصور بن حازم عندما سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام فأجابه:
لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة(3).
وأمّا البطلان الذي أفتى به الكليني - وتبعه السيّد والعمّاني وابن إدريس والحلبي وابن زهرة(4) - فلم نعثر له على دليل في الكافي. واستدلّ له في الجواهر بقاعدة الشغل وإطلاق بعض النصوص التي رواها الشيخ(5).
6 - قال قدس سره:
إن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلّاسجدة أو لم يسجد شيئاً، فعليه إعادة الصلاة(6).
ص: 237
وقد اختار رأيه أيضاً العمّاني. والمشهور شهرة عظيمة نقلاً وتحصيلاً كادت تكون إجماعاً - بل عن بعضهم الإجماع - على أنّه ليس عليه شيء إلّاقضاء السجدة؛ وذلك للإجماع ولخبر ابن حكيم:
إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً، فاقضِ الذي فاتك سهواً(1).
ولم نقف للكليني على رواية في ذلك، واحتمل في الجواهر أن يكون مستنده رواية المعلّى بن خُنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، حيث سأله عن ذلك فأجاب عليه السلام:
... وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة»(2)، معلّقاً عليه: «مع أنّه لا جابر لسنده معارض بما سمعت من الأدلّة المستغنية عن ذكر الترجيح عليه(3).
7 - قال قدس سره:
إن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته، فإذا فرغ سجد سجدتي السهو(4).
والمشهور - بل عليه الإجماع - قضاؤه بعد الصلاة؛ للإجماع والأخبار.
والظاهر أنّ مستند الكليني ما رواه هو عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:
... فإن أنت لم تذكر حتّى تركع، فامضِ في صلاتك حتّى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم(5).
إلّا أنّه أفتى في المواضع التي يجب فيها سجود السهود بقضاء التشهّد أيضاً، قال فيما يجب له سجود السهو:
ص: 238
والذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثالثة، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته(1).
وهناك مجموعة من الآراء المخالفة للمشهور قد نسبها المجلسي الثاني قدس سره في شرحه لكتاب الكافي، مستظهراً ذلك من إيراد الكليني لتلك الأخبار وكأنّه يفتي بمضمونها، وهي بحسب تبويبها الفقهي كالتالي:
1 - روى في الكافي عن محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر اللّٰه ؟ قال: أمّا الطهر فلا، ولكنّها تتوضّأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللّٰه.
قال العلّامة المجلسي تعقيباً على هذا الخبر:
يدلّ على عدم جواز غسل الجمعة للحائض، وعلى رجحان الوضوء لها في أوقات الصلوات، وذكر اللّٰه بقدر الصلاة كما ظهر من غيره. والمشهور فيها الاستحباب، وظاهر المصنّف الوجوب، كما نقل عن ابن بابويه أيضاً لحسنة زرارة، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة(2).
2 - وروي أيضاً عن يونس قال:
سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام، قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: إذا أرادت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، فلا تصلّي إلّاالعصر؛ لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر.
قال العلّامة المجلسي:
ص: 239
يدلّ على أنّ مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة، كما ذهب إليه بعض الأصحاب، ويظهر من المصنّف اختيار هذا القول. والمشهور أنّ الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأوّل والآخر، وهو أحوط(1).
3 - وروي أيضاً عن أبي الجارود، قال:
سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ قتل قمّلة وهو محرم، قال: بئسما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.
وفي روايةٍ أُخرى روى أنّ في ذلك إطعام كفٍّ واحدة. قال العلّامة المجلسي:
المشهور في إلقاء القمّلة أو قتلها كفّاً من الطعام، وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنّف، ولعلّه أقوى، وحمله بعضهم على الضرورة(2).
4 - عنه عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
سألته: متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، فقد انقطع مشيه فليزر راكباً(3).
قال العلّامة المجلسي:
يدلّ على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق، ويجوز له العود إلى مكّة لطواف الزيارة راكباً، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب، والظاهر أنّه مختار المصنّف، ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضاً اختياره(4).
5 - عنه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
ص: 240
الأضحى يومان بعد يوم النحر، ويوم واحد بالأمصار.
قال العلّامة المجلسي:
هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام وفي الأمصار ثلاثة أيّام، وحملها في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب، ويظهر من الكليني قدس سره القول به(1).
6 - عنه، عن يونس بن يعقوب وغيره جميعاً، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها، إلّاإلى شعرها غير متعمّد لذلك.
رواه تحت عنوان: «ما يحلّ للمملوك النظر إليه في مولاته».
قال العلّامة المجلسي:
لعلّ المراد بالتعمّد قصد الشهوة، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع، وحملوا هذه الأخبار على التقيّة(2).
7 - وروي أيضاً في باب «العقيقة ووجوبها» عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام، قال:
العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحبَّ أن يسمّيه من يومه فعل.
قال العلّامة المجلسي:
اختُلف في حكمها، قال السيّد وابن الجنيد: إنّها واجبة، وادّعى السيّد عليه الإجماع، وهو ظاهر الكليني أيضاً، وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب(3).
ص: 241
8 - عنه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّاالأُمّ .
وذكر العلّامة المجلسي:
المشهور كراهة أكله للأبوين، وظاهر المصنّف أنّه لا كراهة إلّاللأُمّ (1).
واستظهار المجلسي؛ لأنّ الكليني عقد الباب تحت هذا العنوان. إلّاأنّ رأيه لا يخلو من غرابة؛ لأنّه روى بعد هذه الرواية ما يدلّ على كراهية ذلك للأبوين معاً، فعن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة»، وقد حمل الفقهاء ما ورد في الأُمّ على الكراهة الشديدة، كما في الروضة وغيرها.
9 - وروى في باب «نفي السارق» عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
إذا أُقيم على السارق الحدّ، نُفي إلى بلدةٍ أُخرى.
قال العلّامة المجلسي:
لم أرَ أحداً تعرّض للنفي في السارق وظاهر المصنّف أنّه قال به(2).
وقال أيضاً معلّقاً على نقل الصدوق لنفس الرواية في الفقيه بعد أن ذكر أنّها صحيحة:
لم يعمل بها الأصحاب غير المصنّف، حتّى أنّه لم يذكره بعنوان الرواية إلّا الأخباريون، وربّما كان لإجمالها، فإنّه ليس فيها مدّة الإخراج، لكنّه لا يكفي ذلك عذراً؛ لأنّه لا يكفي الإخراج بأن يُسمّى إخراجاً، ولو بأن يكون ساعة عن ذلك البلد(3).
والظاهر صحّة ما ذكره لصحّة الرواية، فلا داعي لترك العمل بها أو عدم التعرّض لها.
ص: 242
من أجل أن تتكامل الصورة عن البعد الفقهي لدى فقيهنا الكليني، ذلك البعد الذي بقي غائماً في مجمل نشاطه العلمي، فقد قمنا بتتبّع تراثه الفقهي، وجمع شتاته وتبويبه وترتيبه، عسى أن يكون انطلاقة لدراسة أعمق وأوسع حول البعد الفقهي عند الشيخ الكليني.
الكليني بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، قال:
سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء عليّ عليه السلام إلّامرّة مرّة.
قال الشيخ الكليني معلّقاً على هذا الخبر:
هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة؛ لأنّه - صلوات اللّٰه عليه - كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّٰه طاعة أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه، وأنّ الذي جاء عنهم عليهم السلام أنّه قال: «الوضوء مرّتان» أنّه هو لمن لم يقنعه مرّة واستزاد، فقال:
«مرّتان»، ثمّ قال: «ومن زاد على مرّتين لم يؤجر». وهذا أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء، وكان كمن صلّى الظهر خمس ركعات. ولو لم يطلق عليه السلام في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث(1).
الكليني عن زرارة والفُضيل، قالا: قال أبو جعفر عليه السلام:
إنّ لكلّ صلاة وقتين، غير المغرب، فإنّ وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق.
ص: 243
وروي أيضاً أنّ لها وقتين، آخرُ وقتها سقوط الشفق.
قال قدس سره بعد هذا الخبر:
وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتاً واحداً؛ لأنّ الشفق هو الحمرة، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلّاشيء يسير؛ وذلك أنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلّا قدر ما يصلّي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلّاها على تُؤَدَة وسكون، وقد تفقّدت ذلك غير مرّة؛ ولذلك صار وقت المغرب ضيّقاً(1).
روى الكليني:
عدّة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين - صلوات اللّٰه عليه - لا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل.
قال قدس سره:
معنى هذا أنّه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنّة؛ لأنّ الأوقات كلّها قد بيّنها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، فأمّا القضاء - قضاء الفريضة - وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس(2).
جميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعاً، سبعة منها يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة:
أ. الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتّى يركع.
ص: 244
ب. والذي ينسى ركوعه وسجوده.
ج. والذي لا يدري ركعة صلّى أم ركعتين.
د. والذي يسهو في المغرب والفجر.
ه. والذي يزيد في صلاته.
و. والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شيء.
ز. والذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن يتمّها.
ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ويجب فيها سجدتا السهو:
أ. الذي يسهو فيسلّم في الركعتين ثمّ يتكلّم من غير أن يحوِّل وجهه وينصرف عن القبلة، فعليه أن يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو.
ب. والذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثالثة، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته.
ج. والذي لا يدري أربعاً صلّى أو خمساً، عليه سجدتا السهو.
د. والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلّم بكلامٍ لا ينبغي له، مثل أمر ونهي من غير تعمّد، فعليه سجدتا السهو. فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السهو.
ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو:
أ. الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته - مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم - ثمّ يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة أُخرى فيقضيه، لا سهو عليه.
ب. والذي يسلّم في الركعتين الأُولتين ثمّ يذكر فيتمّ قبل أن يتكلّم، فلا سهو عليه.
ج. ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه.
د. ولا سهو على من خلف الإمام.
ص: 245
ه. ولا سهو في سهو.
و. ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة. فهذه ستّة مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو.
وأمّا الذي يشكّ في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبّر أم لم يكبّر، فعليه أن يكبّر متى ما ذكر قبل أن يركع، ثمّ يقرأ ثمّ يركع، وإن شكّ وهو راكع فلم يدرِ كبّر أو لم يكبّر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه، فإن استيقن أنّه لم يكبّر أعاد الصلاة حينئذٍ.
فإن شكّ وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع، فليركع حتّى يكون على يقينٍ من ركوعه، فإن ركع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع، فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع، فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأنّه قد زاد في صلاته ركعة، فإن سجد ثمّ شكّ فلم يدرِ أركع أم لم يركع، فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكّه، إلّاأن يستيقن أنّه لم يكن ركع، فإن استيقن ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة.
فإن سجد ولم يدرِ أسجد سجدتين أم سجدة، فعليه أن يسجد أُخرى حتّى يكون على يقينٍ من السّجدتين، فإن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين، فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأنّه قد زاد في صلاته سجدة، فإن شكّ بعدما قام فلم يدرِ أكان سجد سجدةً أو سجدتين، فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن أنّه لم يسجد إلّا واحدة، فعليه أن ينحطَّ فيسجد أُخرى ولا شيء عليه، وإن كان قد قرأ ثمّ ذكر أنّه لم يكن سجد إلّاواحدة، فعليه أن يسجد أُخرى، ثمّ يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه، وإن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلّاسجدة أو لم يسجد شيئاً، فعليه إعادة الصلاة(1).
ص: 246
وإن سها فقام من قبل أن يتشهّد في الركعتين، فعليه أن يجلس ويتشهّد ما لم يركع، ثمّ يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته، فإذا فرغ منها سجد سجدتي السّهو، وليس عليه في حال الشكّ شيء ما لم يستيقن(1).
إن شكّ فلم يدرِ اثنتين صلّى أو أربعاً؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه، وإن ذهب وهمه إلى أنّه قد صلّى ركعتين صلّى أُخريين ولا شيء عليه، فإن استوى وهمه سلّم ثمّ صلّى ركعتين قائماً بفاتحة الكتاب، فإن كان صلّى ركعتين كانتا هاتان الركعتان تمام الأربعة، وإن كان صلّى أربعاً كانتا هاتان نافلة(2).
فإن شكّ فلم يدرِ أركعتين صلّى أم ثلاثاً فذهب وهمه إلى الركعتين فعليه أن يصلّي أُخريين ولا شيء عليه، وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي ركعة واحدة ولا شيء عليه، وإن استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلّي ركعة وهو قائمٌ ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتين وهو قاعدٌ بفاتحة الكتاب، وإن كان صلّى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة، والركعتان اللّتان صلّاهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمّت صلاته، وإن كان قد صلّى ثلاثاً فالتي قام فيها تمام الأربع، وكانت الركعتان اللّتان صلّاهما وهو جالسٌ نافلة(3).
ص: 247
فإن شكّ فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً؛ فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي أُخرى ثمّ يسلّم ولا شيء عليه، وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه، وإن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم على حال شكّه وصلّى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان الركعتان نافلة له(1).
فإن شكّ فلم يدرِ أربعاً صلّى أو خمساً؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه، وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة، وإن استوى وهمه سلّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان(2).
روى الكليني عن عبد اللّٰه عليه السلام بن سنان قال:
سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: ما عرف هذا حقّ شهر رمضان، إنّ له في الليل سبحاً طويلاً.
قال الكليني:
الفضل عندي أن يوقّر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار، إلّا أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه، فقد رُخّص له أن يأتي الحلال كما رُخّص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال، قال: ويؤجر في ذلك، كما أنّه إذا أتى الحرام أثم(3).
الكليني عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
ص: 248
قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالساً في دبر الصلاة ؟ قال: أيّ ذلك شاء صنع.
قال الكليني:
وهذا عندي من الأمر المتوسّع، إلّاأنّ الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على طرف البيداء، ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلّاوقد أظهر التلبية، وأوّل البيداء أوّل ميل يلقاك عن يسار الطريق(1).
إنّ اللّٰه - تبارك وتعالى - جعل الدنيا كلّها بأسرها لخليفته، حيث يقول للملائكة: «إِنِّي جٰاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً »(2) فكانت الدنيا بأسرها لآدم، وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه، فما غلب عليه أعداؤهم ثمّ رجع إليهم بحرب أو غلبة سُمّي فيئاً؛ وهو أن يفيء إليهم بغلبة وحرب، وكان حكمه فيه ما قال اللّٰه تعالى: «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ »(3) ، فهو للّٰه وللرسول ولقرابة الرسول، فهذا هو الفيء الراجع؛ وإنّما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم فاُخذ منهم بالسيف. وأمّا ما رجع إليهم من غير أن يوجَف عليه بخيل ولا ركاب فهو الأنفال؛ هو للّٰه وللرسول خاصّة، ليس لأحد فيه الشركة، وإنّما جُعل الشركة في شيء قوتل عليه، فجُعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم، وللرسول سهم، والذي للرسول صلى الله عليه و آله و سلم يقسمه على ستّة أسهم: ثلاثة له، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل.
وأمّا الأنفال فليس هذه سبيلها، كان للرسول صلى الله عليه و آله و سلم خاصّة، وكانت فدك لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم خاصّة؛ لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم فتحها وأمير المؤمنين عليه السلام، لم يكن معهما أحد، فزال عنها
ص: 249
اسم الفيء ولزمها اسم الأنفال. وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصّة، فإن عمل فيها قومٌ بإذن الإمام، فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس، والذي للإمام يجري مجرى الخمس، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كلّه، ليس لأحد فيه شيء. وكذلك من عمّر شيئاً أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض، فليس له ذلك، فإن شاء أخذها منه كلّها، وإن شاء تركها في يده(1).
قال:
إنّ اللّٰه - تبارك وتعالى - جعل الفرائض على أربعة أصناف، وجعل مخارجها من ستّة أسهم:
فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقرّبون لا بغيرهم، ولا يسقطون من الميراث أبداً، ولا يرث معهم أحد غيرهم إلّاالزوج والزوجة، فإن حضر كلّهم قُسِّم المال بينهم على ما سمَّى اللّٰه عزّوجلّ ، وإن حضر بعضهم فكذلك، وإن لم يحضر منهم إلّا واحد فالمال كلّه له، ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرَّب بنفسه وإنّما يتقرّب بغيره، إلّاما خصّ اللّٰه به من طريق الإجماع أنّ ولد الولد يقومون مقام الولد، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة. وهذا من أمر الولد مجمع عليه، ولا أعلم بين الأُمّة في ذلك اختلافاً. فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة.
وأمّا الصنف الثاني فهو الزوج والزوجة، فإنّ اللّٰه عزوجل ثنّى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين، فلهم السهم المسمّى لهم، ويرثون مع كلّ أحد، ولا يسقطون من الميراث أبداً.
وأمّا الصنف الثالث فهم الكلالة؛ وهم الإخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان؛
ص: 250
لأنّهم لا يتقرّبون بأنفسهم وإنّما يتقرّبون بالوالدين، فمن تقرّب بنفسه كان أولى بالميراث ممّن تقرّب بغيره. وإن كان للميّت ولد ووالدان أو واحد منهم، لم تكن الإخوة والأخوات كلالة؛ لقول اللّٰه عزّوجلّ : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاٰلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا» ، يعني الأخ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ»(1) ، وإنّما جعل اللّٰه لهم الميراث بشرط، وقد يسقطون في مواضع(2) ولا يرثون شيئاً، وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبداً. فإذا لم يحضر ولد ولا والدان فللكلالة سهامهم المسمّاة لهم، لا يرث معهم أحدٌ غيرهم إذا لم يكن ولد إلّامن كان في مثل معناهم.
وأمّا الصنف الرابع فهم أُولو الأرحام الذين هم أبعد(3) من الكلالة، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان ولا كلالة، فالميراث لأُولي الأرحام منهم؛ الأقرب منهم فالأقرب، يأخذ كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب بقرابته. ولا يرث أُولو الأرحام مع الولد ولا مع الوالدين ولا مع الكلالة شيئاً، وإنّما يرث أُولو الأرحام بالرحم، فأقربهم إلى الميّت أحقّهم بالميراث، وإذا استووا في البطون فلقرابة الأُمّ الثلث ولقرابة الأب الثلثان، وإذا كان أحد الفريقين أبعد فالميراث للأقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء اللّٰه(4).
إنّ اللّٰه - جلّ ذكره - جعل المال كلّه للولد في كتابه، ثمّ أدخل عليهم بعدُ الأبوين والزوجين، فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة؛ وذلك أنّه عزّوجلّ قال: «يُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ »(5) ، فأجمعت الأُمّة على أنّ اللّٰه أراد بهذا القول الميراث، فصار المال
ص: 251
كلّه بهذا القول للولد. ثمّ فصل الأُنثى من الذكر، فقال: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ »(1) ، ولو لم يقل عزّوجلّ : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » ، لكان إجماعهم على ما عنى اللّٰه به من القول يوجب المال كلّه للولد؛ الذكر والأُنثى فيه سواء، فلمّا أن قال: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » ، كان هذا تفصيل المال، وتمييز الذكر من الأُنثى في القسمة، وتفضيل الذكر على الأُنثى، فصار المال كلّه مقسوماً بين الولد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » .
ثمّ قال: «فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ »(2) ، فلولا أنّه عزّوجلّ أراد بهذا القول ما يتّصل بهذا، كان قد قسّم بعض المال وترك بعضاً مهملاً، ولكنّه - جلّ وعزّ - أراد بهذا أن يوصل الكلام إلى منتهى قسمة الميراث كلّه، فقال: «وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ»(3) ، فصار المال كلّه مقسوماً بين البنات وبين الأبوين، فكان ما يفضل من المال مع الابنة الواحدة ردّاً عليهم على قدر سهامهم التي قسمها اللّٰه - جلّ وعزّ - وكان حكمهم فيما بقي من المال كحكم ما قسّمه اللّٰه عزّوجلّ على نحو ما قسمه؛ لأنّهم كلّهم أُولو الأرحام، وهم أقرب الأقربين، وصارت القسمة للبنات النصف والثلثان مع الأبوين فقط، وإذا لم يكن أبوان فالمال كلّه للولد بغير سهام، إلّاما فرض اللّٰه عزّوجلّ للأزواج على ما بيّناه في أوّل الكلام، وقلنا: إنّ اللّٰه عزّوجلّ إنّما جعل المال كلّه للولد على ظاهر الكتاب، ثمّ أدخل عليهم الأبوين والزوجين.
وقد تكلّم الناس في أمر الابنتين: من أين جُعل لهما الثلثان واللّٰه - جلّ وعزّ - إنّما
ص: 252
جعل الثلثين لما فوق اثنتين ؟ فقال قوم: بإجماع، وقال قوم: قياساً؛ كما إن كان للواحدة النصف كان ذلك دليلاً على أنّ لما فوق الواحدة الثلثين، وقال قوم بالتقليد والرواية.
ولم يُصِب واحد منهم الوجه في ذلك، فقلنا: إنّ اللّٰه عزّوجلّ جعل حظّ الأُنثيين الثلثين بقوله: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » ؛ وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتاً وابناً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين وهو الثلثان، فحظّ الأُنثيين الثلثان، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأُنثيين بالثلثين، وهذا بيان قد جهله كلّهم، والحمد للّٰه كثيراً.
ثمّ جعل الميراث كلّه للأبوين إذا لم يكن له ولد، فقال: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ » ، ولم يجعل للأب تسمية، إنّما له ما بقي. ثمّ حجب الأُمّ عن الثلث بالإخوة، فقال: «فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ »(1) ، فلم يورث اللّٰه جلّ وعزّ - مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلّاالزوج والمرأة، وكلّ فريضة لم يسمِّ للأب فيها سهماً فإنّما له ما بقي، وكلّ فريضة سُمّى للأب فيها سهماً، كان ما فضل من المال مقسوماً على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيّناه أوّلاً.
ثمّ ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمّى لهم، وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع، فاختصرنا الكلام في ذلك.
ثمّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ ، فقال: «وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاٰلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ » ، يعني لأُمّ ، «فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي اَلثُّلُثِ » ، وهذا فيه خلاف بين الأُمّة، وكلّ هذا «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ »(2) . فالإخوة من الأُمّ لهم نصيبهم المسمّى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأُمّ ، والإخوة والأخوات من الأُمّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس، والذكر والأُنثى فيه سواء، وهذا كلّه مجمع عليه، إلّاأن لا يحضر أحد غيرهم، فيكون ما بقي لأُولي الأرحام ويكونوا هم أقرب الأرحام، وذو السهم أحقُّ ممّن لا سهم له،
ص: 253
فيصير المال كلّه لهم على هذه الجهة.
ثمّ ذكر الكلالة للأب؛ وهم الإخوة والأخوات من الأب والأُمّ ، والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب وأُمّ ، فقال: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاٰلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ »(1) ، والباقي يكون لأقرب الأرحام، وهي أقرب أُولي الأرحام، فيكون الباقي لها سهم أُولي الأرحام.
ثمّ قال: «وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ» ، يعني للأخ المال كلّه إذا لم يكن لها ولد، «فَإِنْ كٰانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالاً وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ »(2) .
ولا يصيرون كلالة إلّاإذا لم يكن ولدٌ ولا والدٌ، فحينئذٍ يصيرون كلالة. ولا يرث مع الكلالة أحدٌ من أُولي الأرحام، إلّاالإخوة والأخوات من الأُمّ والزوج والزوجة.
فإن قال قائل: فإنّ اللّٰه - عزّوجلّ وتقدّس - سمّاهم كلالة إذا لم يكن ولد فقال:
«يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاٰلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ» ، فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد، فلم زعمت أنّهم لا يكونون كلالة مع الأُمّ؟!
قيل له: قد أجمعوا جميعاً أنّهم لا يكونون كلالة مع الأب وإن لم يكن ولد، والأُمّ في هذا بمنزلة الأب؛ لأنّهما جميعاً يتقرّبان بأنفسهما، ويستويان في الميراث مع الولد، ولا يسقطان أبداً من الميراث.
فإن قال قائل: فإن كان ما بقي يكون للأُخت الواحدة وللأُختين وما زاد على ذلك، فما معنى التسمية لهنَّ النصف والثلثان؛ فهذا كلّه صائر لهنّ وراجع إليهنّ ، وهذا يدلّ على أنّ ما بقي فهو لغيرهم وهم العصبة ؟
قيل له: ليست العصبة في كتاب اللّٰه ولا في سنّة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، وإنّما ذكر اللّٰه
ص: 254
ذلك وسمّاه؛ لأنّه قد يجامعهنّ الإخوة من الأُمّ ويجامعهنّ الزوج والزوجة، فسمّى ذلك ليدلّ كيف كان القسمة، وكيف يدخل النقصان عليهنّ ، وكيف ترجع الزيادة إليهنّ على قدر السهام والأنصباء إذا كنّ لا يحطن بالميراث أبداً على حال واحدة؛ ليكون العمل في سهامهم كالعمل في سهام الولد على قدر ما يجامع الولد من الزوج والأبوين، ولو لم يسمّ ذلك لم يهتد لهذا الذي بيّناه، وباللّٰه التوفيق.
ثمّ ذكر أُولي الأرحام، فقال عزّوجلّ : «وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ »(1) ؛ ليعيّن أنّ البعض الأقرب أولى من البعض الأبعد، وأنّهم أولى من الحلفاء والموالي، وهذا بإجماع إن شاء اللّٰه؛ لأنّ قولهم: «بالعصبة» يوجب إجماع ما قلناه.
ثمّ ذكر إبطال العصبة، فقال: «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»(2) ، ولم يقل فيما بقي هو للرجال دون النساء، فما فرض اللّٰه - جلَّ ذكره - للرجال في موضع حرم فيه على النساء بل أوجب للنساء في كلّ ما قلَّ أو كثر.
وهذا ما ذكر اللّٰه عزّوجلّ في كتابه من الفرائض، فكّل ما خالف هذا على ما بيّنّاه فهو ردّ على اللّٰه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، وحكم بغير ما أنزل اللّٰه؛ وهذا نظير ما حكى اللّٰه عزّوجلّ عن المشركين حيث يقول: «وَ قٰالُوا مٰا فِي بُطُونِ هٰذِهِ اَلْأَنْعٰامِ خٰالِصَةٌ لِذُكُورِنٰا وَ مُحَرَّمٌ عَلىٰ أَزْوٰاجِنٰا»(3) .
وفي كتاب أبي نعيم الطحّان رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر(4)، عن زيد بن ثابت أنّه قال: «من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء»(5).
ص: 255
الكليني بسنده عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
دخلت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك اللّٰه، إنّ ابنتي هلكت وأُمّي حيّة، فقال أبان: ليس لأُمّك شيء، فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: سبحان اللّٰه! أعطها السدس.
وروي بسنده أيضاً عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
إذا اجتمع أربع جدّات، ثنتين من قبل الأُمّ وثنتين من قبل الأب، طرحت واحدة من قبل الأُمّ بالقرعة، فكان السدس بين الثلاثة. وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأُمّ بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.
قال قدس سره:
هذا قد روي، وهي أخبار صحيحة، إلّاأنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب؛ يرث ميراث الأخ، وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ، يجوز أن تكون هذه أخبار خاصّة، إلّاأنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أطعم الجدّ السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد، وليس هذا أيضاً ممّا يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة(1).
الكليني بسنده عن أبي عمرو المتطبّب، قال:
عرضت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات، فممّا أفتى به أفتى في الجسد، وجعله ستّ فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن والبحح، والشلل من اليدين والرجلين، ثمّ جعل مع كلّ شيء من
ص: 256
هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية.
والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستّة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر. والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين، فهو من ستّة أجزاء الرجل».
قال قدس سره: «تفسير ذلك: إذا أُصيب الرجل من هذه الأجزاء الستّة وقيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر. وكذلك القسامة كلّها في الجروح، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، فإن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرّتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرّات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات، وإن كان كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطى(1).
ص: 257
ص: 258
حيدر محمّد علي السهلاني(1)
قال تعالى في محكم كتابه المبين:
«وَ لِكُلٍّ دَرَجٰاتٌ مِمّٰا عَمِلُوا وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمٰالَهُمْ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ »(2) .
عن أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام، جعفر بن محمّد قال:
إذا كان يوم القيامة، جمع اللّٰه عزّ وجلّ الناس في صعيدٍ واحد، ووضعت الموازين، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيُرّجح مداد العلماء على دماء الشهداء(3).
الحمد للّٰه إقراراً بربوبيته، وإخلاصاً لوحدانيته، وصلّى اللّٰه على محمّدٍ سيّد بريته، وعلى الآل من عترته، وسلّم تسليماً كثيراً، أمّا بعد:
إنّ الثراء العلمي الذي حملته مدرسة الإمامية الروائية ببركة علوم محمّد وأهل بيته صلوات اللّٰه وسلامه عليهم، جعلته من المدارس المهمّة التي استطاعت به بسط
ص: 259
نفوذها في تاريخ الفكر الإسلامي، رغم محاولات الطرف الآخر الحدّ من انتشارها.
قد ساهم ذلك الثراء في إبراز تلك المدرسة بالعديد من الموسوعات الحديثية، أهمّها الكتب الأربعة: الكافي للكليني (ت 329 ه)، وكتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق (ت 381 ه)، وتهذيب الأحكام والاستبصار في مختلف الأخبار للطوسي (ت 460 ه).
وقد كانت هذه الكتب مجال اهتمام جلّ علماء التدوين، فأُلّفت حولها الحواشي والكتب المعتبرة والشارحة لمتونها، والمبينة من صحيح الحديث وضعيفه، وموثقه وحسنه لسندها، فضلاً عن دراستها تاريخياً وفقهياً، وعقيدةً وسلوكاً وأدبياً، وغير ذلك بحسب طريقة الباحث، وهي إلى اليوم ما تزال غضّةً طريّة تنعم بالتحليل والنقد والإضاءات والكشف عمّا حوته من إسرار علوم محمّد وآل بيته عليه السلام.
فكانت قواسم مشتركة بين تلك الكتب، من الأخبار المتعلّقة بالأحكام الشرعية، والتي يبتني عليها المذهب الخاصّ بل الدين عامّة، وفي نفس الوقت هناك من الأخبار المتعارضة التي يمكن في بعض الأحيان إيجاد صيغة جمع بينها، ولكن في البعض الآخر ممّا يكون صريحاً في المعارضة، ويكون هذا الدليل والخبر مبنىً فقهيّ أو أُصولي لصاحب تلك الموسوعة.
في هذه الدراسة المقتضبة حاولت أن أقف على البعض من المباني الفقهية للشيخ علي بن محمّد بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق رحمه الله (ت 381 ه)، في ضوء مباني ثقة الإسلام الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب المعروف بالكليني رحمه الله (ت 329 ه)، وإيجاد الصيغ التوافقية في مبانيهم للأحكام، وإبراز ما اختلفوا فيه رغم قرينة الزمن الذي هم فيه، أسميته ب: «المباني الفقيه للمحدّثين في ضوء كتاب الكافي: الصدوق نموذجاً».
وقد جاءت دراستي لهذا البحث ضمن فصلين:
الفصل الأوّل: مباني الشيخ الصدوق فيما وافق الكليني (المباني المتوافقة).
الفصل الثاني: مباني الشيخ الصدوق فيما عارض الكليني (المباني المتعارضة).
ص: 260
وقبل بيان ذلك لا بدّ من تمهيد:
المبني لغةً : مأخوذ من بَنى يبني بناءً ، يقال: بنى فلان بيتاً من البنيان، وهو مصدر كالغفران، وقال الجوهري:
البنيان: الحائط، فسُمّي به المبنى، مثل الخلق إذا أردت به المخلوق(1).
المبنى اصطلاحاً: وهو متجذّر من التعريف اللغوي، من حيث ما يستفيده الفقيه الباحث من الدليل ويشيد عليه أدلّة بنائه، لذا لا نجد تعريفاً في كتب الفقهاء يحدّد بدقّة تلك الاستفادة، وأقرب ما يمكن أن يقال في بيانه:
المبنى: هو الدليل الذي يلتزم الفقيه به على ما يبتنيه لنفسه من أُسس أُصولية وفقهية ورجالية وعلاجية، عند تعارض الأدلّة في إصدار فتواه، وليست بالضرورة أن تكون موافقة لغيره، وكلّما كثر الفقهاء كثرت احتمالات الاختلاف في المبنى(2).
وتتعدّد تلك المباني بتعدّد نظرة الفقيه إلى جهة الرواية، فمَن سبر طرقها ووقف على وثاقة رجالها ومِن تراكم تلك الروايات، جعل له مبنىً رجالياً اعتمد فيه على توثيق طائفة من الرواة دون غيرهم.
ومَن كانت همّته اكتشاف البعد القاعدي لتقنين القواعد الكلّية الأُصولية، كانت مبانيه أُصولية، ومن جعل دليله أو مستنده رواية معيّنة دون غيرها معارضة لها، كانت مبانيه فقهية، فالتعدّد جهتي اعتباري وليس واقعياً حقيقياً.
والمقصود منه بيان ما أوضحه كلّ من الشيخين، فيما اعتمده في كتبه الروائية من الأحاديث، وعن نظرته في أخذه للروايات من كتب الأصحاب.
ص: 261
فقد ذكر الكليني رحمه الله في مقدّمة كتابه الكافي بعدما رغب أحدهم أن يكون عنده كتاب كافٍ يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكفي المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، والعمل به وفق الآثار الصحيحة الواردة عن الصادقين عليهم السلام، والتي بها يؤدّي فرض اللّٰه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلى الله عليه و آله، فكان جوابه رحمه الله بعد أن يسّر طلب ما أحبّ من التأليف:
اعلم يا أخي أرشدك اللّٰه أنّه لا يسع أحد تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلّاعلى ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله: اعرضوهما على كتاب اللّٰه، فما وافق كتاب اللّٰه عزّ وجلّ فخذوه، وما خالف كتاب اللّٰه فردّوه، وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه.
ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّاأقلّه(1).
فهو تصريح منه رحمه الله في رسم معالم مبناه من أنّ اختلاف الرواية بسبب اختلاف عللها وأسبابها، لا يسع لأحذ تمييزه إلّابما ذكره من شروط العرض على كتاب اللّٰه، أو الأخذ بخلاف ما أخذه القوم، أو المجمع عليه.
والمراد من الروايات المختلفة: التي لا تحتمل الحمل على معنىً يرتفع به الاختلاف.
وبالمقابل أوضح الصدوق رحمه الله في مقدّمة كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه الأُسس الكفيلة في رسم معالم مبانيه، من خلال ما يفتي به في ذلك الكتاب، بعدما طلب أحدهم تصنيف كتاب في الفقه في الحلال والحرام والشرائع والأحكام، فأجابه إلى ذلك بقوله:
وصنعت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد؛ لئلّا تكثر طرقه، وإن كثرت فوائده، ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به
ص: 262
وأحكم بصحّته، وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مُستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع...(1).
فهذا إذعان بصحّة مرويات مصنَّفه رحمه الله؛ لأنّه كتاب فتوى، وخصوصاً كتاب الصدوق، كتاب حديثي تنتهي فتواه بالأعمّ الأغلب إلى مرويات الأئمّة عليهم السلام، ولذا قيل:
«إذا اعوزتنا النصوص، رجعنا إلى كتب ابن بابويه».
وكتب الفتوى هي عصارة ما تبنّاه الفقيه من مبانيه، اجتمعت فيه المباني الفقهية والرجالية والأُصولية وغيرها.
ولكن ليس بالضرورة أن تكون تلك المباني موافقة لغيره من حيث الطرح والأخذ، فمجال الأخذ بها والعمل وفقها بعد تحقيقها يعود إلى الاطمئنان النفسي والقطع بها.
مضافاً إلى ذلك أنّ آراء ومباني القدماء يمكن تحصيلها من عناوين أبواب كتبهم الروائية وما يفتونا به، وما يلتزمون به عملاً وفقهاً.
وإذا كان كلّاً من المحدّثَين (الكليني والصدوق) لا ينقل إلّاما يراه صحيحاً، فيمكن أن يقال بعدم أهمّية كتاب كتاب من لا يحضره الفقيه، والاعتماد على الكافي، ولكن يمكن دفع هذا التنافي:
1 - لا يدلّ تأليف الفقيه على ضعف الكافي عنده، ودليل هذا كما سيأتي في قول الصدوق في باب (الوصي يمنع الوارث)، فإنّه لا ينقل في الباب الذي ذكره إلّارواية للكليني ويبني حكمه عليها وفق مبنى الكليني.
2 - جعل الصدوق له طريقاً إلى الشيخ الكليني عن طريق مشايخه، كما سيتّضح ذلك بعد إن شاء اللّٰه. ومنه يظهر مواكبة الصدوق للكليني في عرض روايات أهل البيت عليهم السلام والاعتماد في نقله على بعض روايات الكافي.
ص: 263
اعتمد الصدوق رحمه الله في جملة من مبانيه الفقهية على عدّة روايات نقلها من كتاب الكافي، وأوضح في مشيخته الطريق إلى الكليني:
وما كان فيه عن محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد رويته عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، وعلي بن أحمد بن موسى، ومحمّد بن أحمد السناني (رضي اللّٰه عنهم)، عن محمّد بن يعقوب الكليني، وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم، عنه، عن رجاله(1).
والثلاثة من مشايخ الصدوق ترضّى عنهم في المشيخة، وذكر ما نقل عنهم في كتبه، نعم قد يذكر السناني بالإهمال والذمّ ، ولكن يمكن تصحيح هذا الوجه بما ذكره الأردبيلي بقوله:
ولم يذكر الأخير إلّامهملاً أو مذموماً، إلّاأنّ اجتماعهم - أي الثلاثة - يصحّح الصدق(2).
ولعلّ من صحّح هذا الطريق لذلك صاحب منهج المقال أيضاً(3).
وهي تلك المباني التي وافق فيها الصدوق رحمه الله الكليني رحمه الله فيما نقله عنه أو عن غيره، وقد تكون أُطروحه تلك المباني من التوافق في موردين:
وقد تعدّدت جهات نقله لتلك المباني بطرق عديدة، منها:
الطريق الأوّل: ما تفرّد الصدوق رحمه الله في تثبيت مبنىً له من خلال ما نقله من رواية ليس لها طريق إلّامحمّد بن يعقوب الكليني، فقد ذكر في باب الوصي يمنع الوارث
ص: 264
ماله بعد البلوغ فيزني لعجزهِ عن التزويج، نقلاً عن الكافي:
روى محمّد بن يعقوب الكليني رضي اللّٰه عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن قيس، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال في رجلٍ مات وأوصى إلى رجلٍ وله ابن صغير، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: ردّ عليّ مالي لأتزوّج، فأبى عليه، فذهب حتّى زنى. قال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج(1).
وقد علّق الصدوق رحمه الله على هذه الرواية بقوله:
قال مصنّف هذا الكتاب: ما وجدت هذا الحديث إلّافي كتاب محمّد بن يعقوب، وما رويته إلّامن طريقه، حدّثني به غير واحد، منهم محمّد بن محمّد بن عصام الكليني رضي للّٰه عنهم، عن محمّد بن يعقوب(2).
فهو موافق لمبنى الشيخ الكليني رحمه الله وحدّد به معالم ذلك المبنى بما نقله عن الكليني، ولم ينقل الصدوق في الفقيه إلّاهذه الرواية في بابها.
وظاهره العمل بها؛ لأنّه لم يذكر لعنوان الباب غير هذه الرواية، بل نقله لعنوان الباب هذه الرواية فقط تقويةً وتصحيحاً منه لها وحكم بصحّتها، وإلّا لا وجه لذكره، وهو كما ترى صريح في أنّ الكافي كان عنده وأخذ الحديث منه(3).
والظاهر أنّ الصدوق رحمه الله لم يصرّح في الفقيه بمثل هذا التفرّد من النقل والبناء عليه إلّا في هذا المورد المتقدّم.
الطريق الثاني: ما يتبنّاه الصدوق رحمه الله وفق مباني الكليني رحمه الله لفظاً ومعنىً ، ومثل هذا كثير، وعلى نحو المثال:
1 - فقد روى الكليني رحمه الله في باب وجوب الصلاة:
عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: فرض اللّٰه الصلاة، وسَنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله على عشرة
ص: 265
أوجه: صلاة السفر والحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميّت(1).
المستفاد من هذا التقسيم أنّ الكلّ فريضة، وتتحصّل بتحصيل سببها من تلك الوجوه؛ السفر أو الحضر أو الخوف وغيرها.
وإن لم يكن في تعداد هذه الفروض صلاة ركعتي الطواف، وهي ممّا لا شك من أفراد الصلاة الواجبة، وعدم الذكر لها يتحقّق منه لاحتمالين:
الاحتمال الأوّل: كون المراد من التقسيم ما شرع من الصلاة لأجل نفس الصلاة، لا أنّها تابعة لطوافٍ أو غيره(2).
الاحتمال الثاني: إنّ التقسيم مطلق، وصلاة الطواف أو غيرها قيّدتها النصوص من آيةٍ أو روايةٍ بشأنها(3).
وقد تبنّى الصدوق رحمه الله هذا التقسيم، وروى هذه الرواية بمثلها في الفقيه(4) وبإسنادٍ غير إسناد الكليني، بل بإسناده عن زرارة. ورواها في الخصال عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بمثل نصّ الكليني.
2 - ما رواه الكليني رحمه الله بسندٍ صحيح عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرير (عن زرارة)، عن محمّد بن مسلم، قال:
قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتُقسَم، فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تُقسَم ؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها، فهو لها ضامن حتّى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها، فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يُوصى إليه، يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربَّه
ص: 266
الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان(1).
ولا ريب ولا إشكال في الضمان إذا كان التأخير لغير عذر، وقد استدلّ الفقهاء بهذه الرواية على الضمان في الأوّل وعدمه في الثاني(2).
ومثل هذه الرواية تبنّاها الصدوق(3) رحمه الله لفظاً ومعنىً وحكماً في إحدى مروياته عن محمّد بن مسلم.
3 - ما رواه الصدوق رحمه الله مثل الحديث المروي في الكافي مع اختلاف السند، فقد روى بشأن العمرة في أشهر الحجّ عن معاوية بن عمّار، قال:
سُئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ أفرد الحجّ ، هل له أن يعتمر بعد الحجّ؟ فقال: نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن(4).
وفي الكافي عن عبد الرحمٰن، عن أبي عبد اللّٰه مثله(5).
فالرواية تحدّد أنّ مَن حجّ حجّ الإفراد أتى بالعمرة بعد الحلق تمكين الموسى من رأسه، وفيه إشارة إلى جواز التأخير إلى بعد أيّام التشريق؛ لما روي أنّ الإقامة بمعنى أفضل، واختلافها عمّن فاتته عمرة التمتّع وأقام إلى هلال محرّم، اعتمر وأجزأت عنه وكانت مكان عمرة المتعة.
وغيرها من الروايات التي ينقلها الصدوق بالمثل(6).
الطريق الثالث: ما يتبنّاه الصدوق رحمه الله وفق مباني الكليني رحمه الله وينقله بالمعنى فقط دون النصّ لفظاً. وهذا الوجه في التبنّي يحصل في كتب الصدوق رحمه الله بكثرة، خصوصاً بعد
ص: 267
الالتفات إلى ما صرّح به في مقدّمة الفقيه بأنّ إعداده لهذا الكتاب كتاب فتيا، وعادة كتب الفتيا أنّها تترجم نصوص أهل البيت عليه السلام إلى معاني تلك النصوص، فمن ذلك:
1 - ما رواه الصدوق في معرض حديثه عن أحكام كفّارات صيد المحرم، فقد روى عن حفص بن البختري(1)، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فيمن أصاب صيداً في الحرم، قال:
إن كان مستوي الجناح فليُخلِّ عنه، وإن كان غير مستوٍ نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه(2).
والمقصود من النتف: هو نزع الريش، والغرض منه أن يسرع نبات الريش، وظاهر «فلينتف» الوجوب.
هذا التبنّي من القول والمروي من الصدوق مأخوذ بالمعنى عمّا رواه الكليني رحمه الله، كما جاء في صحيحه داوود بن فرقد، قال:
كنّا عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام بمكّة، وداوود بن علي بها حاكم مكّة، فقال لي أبو عبد اللّٰه عليه السلام: قال لي داوود بن علي: ما تقول يا أبا عبد اللّٰه في قَماريّ اصطدناها وقصّيناها؟ فقلت تُنتف وتُعلف، فإذا استوت خُلّي سبيلها(3).
وأصل «قصّيناها»: قصصناها، أُبدلت الثانية ياءً .
فالحكم من حيث النتيجة واحد، وإن اختلفت كلمات الروايتين.
2 - روى الصدوق في باب آداب الصائم ما ينقض صومه وما لا ينقضه، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:
إنّ الكذب على اللّٰه وعلى الأئمّة يُفطّر الصائم(4).
ص: 268
والظاهر أنّه منقول بالمعنى، فإنّ الحديث المروي عن الكليني رحمه الله هكذا: «سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتُفطّر الصائم، قال: قلت: هلكنا، قال: ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على اللّٰه عزّ وجلّ وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام»(1).
وقد اختلف الفقهاء في فساد الصوم بالكذب على اللّٰه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله وعلى الأئمّة عليهم السلام، بعد اتّفاقهم على أنّ غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم وإن كان مُحرّماً.
3 - ما رواه الصدوق في شهود رؤية الهلال: «قال علي عليه السلام: لا تُقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، إلّاشهادة رجلين عدلين»(2).
وذكر العلّامة وجهاً في عدم الاعتبار: «ولأنّها عبادة، فاعتُبر عددها بأعمّ الشهادات وقوعاً، اعتبار بالأعمّ الأغلب»(3).
ورواه الكليني عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «قال علي عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا تجوز إلّاشهادة رجلين عدلين»(4).
وعلّل السيّد المرتضى عدم الجواز بما انفردت به الإمامية في هذه الشهادة بعد الإجماع؛ لأنّ الصيام من الفروض تأكّده، فعدم جواز قبول الشهادة تأكيداً وتعظيماً، فإنّ شهادتهنّ لم تسقط إلّامن حيث التغليظ(5).
4 - مرسلة الصدوق في الحجّ ، روى:
إنّ الحاجّ مِن حين يخرج من منزله حتّى يرجع، بمنزلة الطائف بالكعبة(6).
ص: 269
ففيه إشارة إلى أخذه من حيث المعنى إلى ما ذكره الكليني رحمه الله في حسنه زياد القندي، قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: جُعلت فداك، إنّي أكون في المسجد الحرام فأنظر إلى الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد، فاغتمّ لذلك، فقال: يا زياد، لا عليك، فإنّ المؤمن إذا خرج من بيته يؤمّ الحجّ ، لا يزال في طوافٍ وسعي حتّى يرجع(1).
والمبنى الروائي للشيخين - المتوحّد من حيث المعنى - يبيّن ما للحاجّ من مكانة من حين يخرج من منزله حتّى يرجع، فهو بمنزلة الطائف والساعي، ولا يجري عليه القلم ما لم يأتِ بشيءٍ يبطل حجّة، وقد ورد بهذا العديد من الروايات(2).
وهي تلك المباني التي جاءت منسجمة مع ما نقله الصدوق من الكتب ومن ضمنها الكافي، والتي حدّد فيها مبنى حُكمه على نوع من أنواع الأحكام الشرعية، إلّا أنّها خالفت المشهور:
1 - فقد نقل الصدوق في باب نادر وتابع إلى صيام شهر رمضان، وفي ذلك الباب جملة من الروايات نقلها من عدّة كتب وعدّة طرق تكشف عن مبناه في إثبات عدة أيّام شهر رمضان المبارك، فقد ذهب رحمه الله إلى ما حاصله: إنّ عدة شهر رمضان ثلاثون يوماً، لا ينقص أبداً، عكس شهر شعبان الذي لا يتمّ أبداً.
وكان في جملة ما نقله من الروايات، رواية عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب، عن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
قلت له: إنّ الناس يروون أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً أكثر ممّا صام ثلاثين، قال: كذبوا، ما صام رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله إلّاتامّاً، ولا تكون ناقصه،
ص: 270
إنّ اللّٰه تبارك وتعالى خلق السنة ثلاثمئة وستّين يوماً، وخلق السموات والأرض في ستّة أيّام، فحجزها من ثلاثمئة وستّين يوماً، فالسنة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوماً، وشهر رمضان ثلاثون يوماً؛ لقول اللّٰه عزّ وجلّ : «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » ، والكامل تامّ ، وشوال تسعة وعشرون يوماً، وذو القعدة ثلاثون يوماً؛ لقول اللّٰه عزّ وجلّ : «وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلاٰثِينَ لَيْلَةً » ، فالشهر هكذا، أي شهر تامّ وشهر ناقص، وشهر رمضان لا ينقص أبداً، وشعبان لا يتمّ أبداً(1).
وقد رواه الكليني(2) رحمه الله في النوادر مع اختلاف بسيط في اللفظ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.
وجهة المخالفة تكمن في أنّ الرواية التي ذكرها الكليني وصحّحها الصدوق، بل بالغ الصدوق في جهة تصحيحها وأوجب العمل بها، ولم يجعل طريقاً لطرحها، قد تعرّض لها الشيخ المفيد قدس سره في بعض رسائله وناقش سندها، واعتبرها ومن مثلها من الروايات الشاذّة ولا يمكن الاستدلال بها، قال:
وأمّا ما تعلّق به أصحاب العَدد من أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يوماً، فهي أحاديث شاذّة قد طعن نُقّاد الآثار من الشيعة في سندها، وهي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها(3).
وبالإضافة إلى ما تقدّم فقد روى الصدوق أيضاً أربعة روايات بهذا المضمون بطرق متعدّدة، وعقّب بعد ذلك بقوله:
قال مصنّف هذا الكتاب: مَن خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدّها اتُّقِيَ كما يُتَّقي العامّة، ولا يُكلّم إلّابالتقيّة، كائناً من كان، إلّاأن يكون مسترشداً فيُرشد ويُبيّن له، فإنّ البدعة إنّما تُماث وتُبطل بترك ذكرها، ولا قوّة إلّا باللّٰه(4).
ص: 271
وهو بهذا يغلق على من يريد تصحيح هذه الأخبار بأحد أوجه الجمع، أو حملها على أحد موارد الاحتمالات المصحّحة.
وقد تصدّى العديد من الأكابر في نفي هذه الأمر أو إثباته(1)، وأنّ معظم الأصحاب على خلافه، وردّوا تلك الأخبار إمّا بضعف السند، أو بالشذوذ ومخالفة المحسوس والأخبار المستفيضة، أو حملوها على معانٍ صحيحة.
وقد علّق صاحب كتاب الوافي(2) على هذه الروايات وطرحها بعدم جواز العمل بها، ولعدّة وجوه:
منها: لا يوجد شيء من هذه الأخبار في الأُصول المصنّفة، وإنّما هي موجودة في الشواذّ من الأخبار.
ومنها: إنّ الروايات مختلفة الألفاظ مضطربة المعاني؛ لروايتها تارةً عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام بلا واسطة، وأُخرى بواسطة، وأُخرى يفتي بها الراوي من قبل نفسه فلا يسندها إلى أحد.
ومنها: إنّها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة.
ومنها: وجود بعض التعاليل الروائية كاشفة على أنّها غير صادرة من إمام هدى، مثل اتّفاق تمام ذي القعدة في أيّام موسى عليه السلام، لا يوجب تمامه في مستقبل الأوقات.
2 - روى الصدوق رحمه الله بشأن يوم النحر عن كُلَيب الأسدي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
سألته عن النحر؟ فقال: أمّا بمنىً فثلاثة أيّام، وأمّا في البلدان فيوم واحد(3).
ص: 272
وهو موافق لما رواه من حيث المبنى للكليني رحمه الله كما جاء ذلك في صحيحة جميل بن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
الأضحى يومان بعد يوم النحر، ويوم واحد بالأمصار(1).
وهو خلاف ما ذهب إليه المشهور من أنّ الذبح في منىً أربعة، وفي الأمصار ثلاثة، ولكن يمكن تصحيح هذا القول وجعله موافقاً للمشهور، وذلك بمبنيين:
المبنى الأوّل: حمل أيّام النحر على عدم جواز الصوم فيها.
فقد ذكر الصدوق رحمه الله في الفقيه قبل رواية كُلَيب رواية عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
سألته عن الأضحى بمنىً؟ قال: أربعة أيّام. وعن الأضحى في سائر البلدان ؟ قال:
ثلاثة أيّام...(2).
وقد عقّب الصدوق رحمه الله على هذين الحديثين بعدم المنافاة بينهما، قائلاً:
قال مصنّف هذا الكتاب: هذان الحديثان متّفقان غير مختلفين؛ وذلك أنّ خبر عمّار هو الأضحية وحدها، وخبر كُلَيب للصوم وحده، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عَميرة....
وكذلك حمل الشيخ(3) في التهذيب روايتي جميل وكُلَيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم.
المبنى الثاني: الحمل على الأفضلية أو على تأكيد الاستحباب.
وهو ما ذهب إليه صاحب مدارك الأحكام بعد استشكاله على الصوم ومصادفته مع أيّام التشريق، فقال:
ومقتضى هذا الحمل عدم تحريم الصوم يوم الثالث من أيّام التشريق، وهو مشكل؛ لأنّه مخالف لما أجمع عليه الأصحاب ودلّت عليه أخبارهم، والأجود حمل روايتي محمّد بن مسلم وكُلَيب الأسدي على أنّ الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار في يوم
ص: 273
النحر وفي منىً ، أو في اليومين الأوليين من أيّام التشريق(1).
وهي تلك المباني التي عارض فيها الشيخ الصدوق رحمه الله الكليني رحمه الله فيما نقله عنه أو عن غيره من الأحكام، وهي من المباني الخلافية بين الشيخين، ولكن فيما يبدو أنّها من المباني المحتملة الموافقة على غرار مبنى الكليني، وقد استطاع الفقهاء أن يجدوا بين تلك الأخبار المتعارضة صيغة جمع بينها، فيكون التعارض تعارضاً بدوياً غير مستقرّ.
تعدّ مسألة صلاة المسافر بعد اجتماع الشرائط المذكورة فيها وجوب القصر، وهذا الوجوب عزيمة لا رخصة، وذلك بحذف أخيرتي الرباعية، وعدّ هذا من ضروريات مذهب الإمامية، وعليه أكثر العامّة(2).
إلّا أنّه ورد في الأخبار المستفيضة بالإتمام في الأماكن الأربعة (مكّة، والمدينة، والكوفة، والحائر الحسيني).
وأورد الشيخ الكليني عند تعرّضه في أحد أبواب إتمام الصلاة في الحرمين (مكّة والمدينة)، فقد ذكر ثمان روايات تدلّ بظاهرها على:
أوّلاً: وجوب الإتمام، وتدلّ عليه صحيحة إبراهيم بن شيبة، قال:
كتبتُ إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فكتب إليَّ : كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين، فأكثر فيها وأتمّ (3).
فإنّ ظاهر قوله «وأتمّ » وجوب الإتمام فيهما، كما واستظهر المرتضى رحمه الله هذا
ص: 274
الوجوب في جميع المواطن الأربعة، بل تعدّى حتّى مشاهد الأئمّة عليهم السلام، حيث قال: لا تقصير في مكّة ومسجد النبي صلى الله عليه و آله ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمّة القائمين مقامه عليه السلام(1).
بل صحيحة علي بن مهزيار دلّت على رجحان الإتمام في جميع مكّة والمدينة، وأنّه لا يشمل جميع الحرمين.
عن علي بن مهزيار قال:
كتبتُ إلى أبي جعفر عليه السلام: إنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير في الحرمين، فمنها: بأن يتمّ الصلاة ولو واحدة، ومنها: أن يقصر ما لم ينوِ مقام عشرة أيّام، ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليَّ بالتقصير، إذ كنت لا أنوي مقام عشرة أيّام، فصرت إلى التقصير، وقد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك ؟
فكتب إليَّ بخطّه: قد علمت - يرحمك اللّٰه - فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فإنّي أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيها الصلاة.
فقلت له بعد ذلك بسنين مشافهةً : إنّي كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم، فقلنا: أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال: مكّة والمدينة(2).
وحدود مكّة والمدينة أوسع وأكبر من حدود حرميهما.
وذكر الشيخ الكليني رحمه الله في بابٍ مستقلّ من أبواب الزيارات بحدود الستّ روايات، ظاهرها الإتمام في الأماكن الأربعة، ومنها:
صحيحة إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام(3).
ص: 275
فالرواية ظاهره من صيغة الأمر الدالّة على الوجوب، بغضّ النظر عن سعة حدود تلك الأمكنة وضيقها.
ثانياً: وجوب التقصير: أي مساواة الأماكن الأربعة لغيرها من الأماكن في وجوب التقصير، ما لم ينقطع سفره بأحد قواطع السفر المذكورة.
وإلى هذا ذهب الشيخ الصدوق حيث عقّب رحمه الله بعد المرسلة التي ذكرها في الفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام:
من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: مكّة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين عليه السلام(1).
قال مصنّف هذا الكتاب: يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيّام في هذه المواطن حتّى يتمّ ، وتصديق ذلك ما رواه محمّد بن إسماعيل، عن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:
سألته عن الصلاة بمكّة والمدينة، يقصر أو يتمّ؟ قال: قصِّر، ما لم تعزم على مُقام عشرة أيّام(2).
فالرواية دالّة على عدم وجوب التمام حتّى يعزم المسافر على الإقامة في ذلك المكان.
بل ذكر في علل الشرائع، أنّ مكّة والمدينة كسائر البلدان، كما في صحيحة معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: مكّة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال: نعم، قلت: قد روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم أتمّو بالمدينة بخمس، فقال: إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة، فكرهت ذلك لهم فلذلك قلته(3).
ص: 276
وتبع الشيخ الصدوق على هذا المبنى القاضي ابن البَرّاج على ما حُكي عنه(1)، بل الشيخ في الاستبصار والتهذيب(2)، على احتمال، وذكر بحر العلوم في مصابيحه أنّه المشهور بين القدماء(3).
ثالثاً: التخيير بين التقصير والإتمام.
وتدلّ عليه رواية الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال:
قلت له: إنّا إذا دخلنا مكّة والمدينة نتمّ أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذاك، وإن أتممت فهو خيرٌ يُزاد(4).
فالترديد شاهد حال على التخيير في تلك الأماكن، وهذا مبنى الأكثر من الفقهاء بما فيهم الكليني، بل ادُّعي عليه الإجماع كما عن العلّامة في التذكرة(5)، والشهيد الأوّل في الذكرى(6)، وفي الجواهر:
فإنّي لا أجد فيه خلافاً إلّامن ظاهر الصدوق أو صريحه(7).
وعلى هذا الرأي فقهاؤنا المعاصرون(8).
فلمّا كانت الأقوال متعدّدة، هل يمكن توجيه مبنى الصدوق رحمه الله على ما يوافق مبنى الكليني رحمه الله على القول بوجوب القصر، على ما يوافق المشهور والكليني في قولٍ
ص: 277
آخر؟
فالكلام في موردين:
المورد الأوّل: توجيه مبنى الصدوق مع مبنى القول بوجوب الإتمام، وذلك بعدّة وجوه:
الوجه الأوّل: الجمع العرفي:
لمّا كان مبنى الصدوق وجوب التقصير وشأنية تلك الأماكن شأنية غيرها من مواطن السفر، على عكس مبنى الكليني من وجوب الإتمام في الأماكن الأربعة، وكلّ اعتمد ما يؤيّد قوله بطائفة من الأخبار، فكانت تلك الأخبار متعارضة، ويمكن إيجاد وجه جمع بينهما، بل أوجب النراقي رحمه الله وجوب الجمع حيث قال:
إنّه تعارض الفريقان من الأخبار، فيجب الجمع بينهما بالحمل على التخيير، إمّا لأنّه المرجع عند التعارض وعدم الترجيح، أو لشهادة الأخبار(1).
ومن الأخبار التي تصلح أن تكون شاهداً ما ذُكر في الكافي، كرواية علي بن يقطين عن التقصير بمكّة فقال:
أتِمّ وليس بواجب، إلّاأنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي(2).
وراوية ابن المختار:
إنا إذا دخلنا مكّة والمدينة نتمّ أو نقصر؟ قال: إن قَصَرت فذاك، وإن أتممت فهو خيرٌ تزداد(3).
الوجه الثاني: يمكن ترجيح أدلّة القول بالتقصير على ما ذهب إليه الشيخ الصدوق رحمه الله، وذلك لعدّة اعتبارات:
الاعتبار الأوّل: الرجوع إلى عمومات صلاة القصر للمسافر.
الاعتبار الثاني: تقديم الأخصّ على الأعمّ ؛ وذلك لأنّ الروايات التي ذكرها الكليني رحمه الله دالّة بعمومها على إتمام الصلاة، سواء قصد الإقامة أم لم يقصدها، عكس
ص: 278
مرويات الصدوق رحمه الله المحمولة على الإتمام بنيّة قصد الإقامة عشرة أيّام.
الاعتبار الثالث: الصلاة مع الإتمام مبني على التقيّة موافقةً للعامّة.
ويمكن مناقشة هذا الوجه بكلّ اعتباراته، وذلك من خلال:
ما يردّ الاعتبار الأوّل: إنّ الرجوع بعد تعارض روايات الشيخ الكليني الدالّة على تعيين الإتمام، ومرويات صاحب الفقيه إلى تعيين القصر إلى العمومات الدالّة على تعيين القصر، إنّما يُرجع إليه إذا لم يكن هناك مرجع فوقاني يُرجع إليه، وفي هذه المسألة يمكن الرجوع، هو ما صرّحت به الروايات بالتخيير، نحو صحيحة علي بن يقطين، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكّة ؟ فقال: أتِمّ وليس بواجب، إلّاأنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي(1).
ما يردّ الاعتبار الثاني: إنّ تقديم الخاصّ على العامّ غير جارٍ هنا؛ وذلك لورود عدد من الروايات والتي فيها الأمر بالتمام بمجرّد المرور في البلد، كما في رواية قائد الحنّاط عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال:
سألته عن الصلاة في الحرمين ؟ فقال: أتِمّ ولو مررت به مارّاً(2).
أو الروايات الدالّة على الإتمام بيوم الدخول، كما في صحيحه مسمع عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
قال لي: إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل(3).
أو بمجرّد صلاة واحدة، كما في صحيحة عثمان بن عيسى، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ؟ فقال: أتمّها ولو صلاةً واحدةً (4).
ص: 279
فيكون هذا الاعتبار مردود من جهة عدم صلاحية هذا التخصيص حتّى يكون حاكماً على أدلّة التقديم.
ما يردّ الاعتبار الثالث: القول بالتقيّة موافقةً للعامّة، لا يصحّ الركون إليه في هذا المجال؛ لأنّ من خالف الإمامية من فقهاء الجمهور وعند تعرّضهم لأحكام صلاة المسافر على قولين، من دون أن يفرّقوا بين مكانٍ وآخر، فاختار أبو حنيفة تعيين القصر، والشافعي وجمع من أصحابه - منهم عثمان وعائشة - ثبوت التخيير بين القصر والإتمام، ولم يفت أحد منهم بتعيين الإتمام مطلقاً حتّى في الحرمين(1).
وعلى هذا لا تكون أخبار تعيين الإتمام موافقة للعامّة، بل أصل الجواز بحسب ما تقدّم من أدلّة الشيخ الكليني رحمه الله ومن وافقه.
فإذن، لم تثبت الموافقة للعامّة على نحو الموجبة الكلّية.
المورد الثاني: توجيه مبنى الصدوق رحمه الله مع القول بحمل الأخبار الدالّة على الأفضلية أو التخيير، وذلك بحمل ما ذهب إليه الشيخ الصدوق القول بالقصر على التقيّة جميعاً، بين ما ذكره من أخبار وبين أخبار الإتمام المحمولة على الأفضلية، وبين أخبار التخيير، وذلك من خلال(2):
أوّلاً: العامّة لا ترى خصوصية لهذه الأماكن.
ثانياً: الروايات الصريحة والدالّة على أنّ الصلاة في تلك الأماكن بالتمام من الأمر المذخور في علم اللّٰه المخزون، وهو خاصّ بالشيعة، ومن يستكشف أنّ الأمر بالقصر على خلاف ذلك فيكون للتقيّة لا محالة.
ثالثاً: ما استدلّ به الشيخ الصدوق من رواية ابن وهب، قال:
ص: 280
قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: مكّة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال: نعم، قلت: قد روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم أتمّو بالمدينة بخمس، فقال: إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة، فكرهت ذلك لهم فلذلك قلته(1).
فالتقيّة ظاهرة في الرواية، وذلك من خلال:
أ. كيف يأمر الإمام عليه السلام بالإتيان بغير المأمور به.
ب. إنّ التمام مشروع في حدّ نفسه، وإلّا إذا لم يكن مشروعاً ولا صحيحاً، فهل مجرّد الخروج والناس يستقبلونهم من مسوغات التمام ؟ فيكون نفس هذا البيان شاهد صدق على استناد الأمر بالقصر إلى التقيّة(2).
وبهذا يمكن الجمع بين المبنيين (وجوب القصر والأخبار الدالّة على الترجيح والأفضلية)، دون الجمع بين أخبار وجوب القصر وأخبار وجوب الإتمام.
فعن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: قال:
قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ؟ قال: لا بأس(3).
فالرواية مخالفة للمشهور من اشتراط التقابض في المجلس بشأن بيع النقدين، وهي معارضة لمبنى الكليني، لما رواه في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضّة بفضّة إلّايداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضّة إلّا يداً بيد(4).
فالروايتان صريحتان بالتعارض، إلّاأنّ الفقهاء وجّهوا رواية الصدوق وجعلوها
ص: 281
موافقة لمبنى الكليني من عدّة وجوه، منها:
الوجه الأوّل: ذكره بعض المحقّقين من حمل خبر عمّار الساباطي على ما إذا كان أحد النقدين في ذمّة أحدهما نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقدٍ آخر، فيكون في ذمّته المال بمنزلة الوكيل في القبض، فقوله: «نسيئة» ليس قيداً للبيع حتّى يكون خلاف المشهور وخلاف الإجماع، بل إمّا قيد للدنانير ويكون قوله «يبيع» بمعنى يشتري، وإمّا قيد للدراهم و «يبيع» على معناه الظاهر، وعلى التقديرين يكون موافقاً لفتوى الأصحاب(1).
الوجه الثاني: ضعف طريق الشيخ إلى عمّار الساباطي، فقد ضعّفه بعض علماء الرجال(2)، وذلك لفساد مذهبه وأنّه فطحي، وإن كان موثّقاً، والخبر قد تفرّد به وحده.
غير أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله لم يقبل الطعن عليه بهذه الطريقة، فهو ثقة في النقل لا طعن عليه، والاحتياط ينبغي أن لا يُترك مهما أمكن(3).
الوجه الثالث: الحمل على التقيّة وأشار إليه المحقّق البحراني(4).
الصدوق في باب الرهن حكم - من خلال ما رواه - بأنّ القول قول المرتهن عند الاختلاف بالرهن، وذكر لفتواه ما رواه عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه السلام، قال:
قال علي عليه السلام: في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، أنّه يُصدّق قول المرتهن حتّى يحيط بالثمن؛ لأنّه أمين(5).
ص: 282
فيكون القول قول القابض، وعلى المالك البيّنة، وإليه أشار الصدوق في المقنع(1)، وهي معارضة لمبنى الكليني لما رواه في صحيحة محمّد بن مسلم:
عن أبي جعفر عليه السلام، في رجلٍ يرهن عند صاحبه رهناً لابيّنة بينهما فيه، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف، فقال صاحب الرهن: إنّما هو بمئة، قال: البيّنة على الذي عنده الرهن، وإن لم يكن بيّنة فعلى الراهن اليمين(2).
ووجّه صاحب المسالك(3) مبنى الكليني رحمه الله بأنّه الأقوى، بعد أن قال: إنّ ذهاب الأكثر إلى هذا القول، معلّلاً ذلك بعدّة أُمور: بأصالة عدم الزيادة، وبراءة ذمّة الراهن، ولأنّه منكر. واستدلّ العاملي بعد ذلك بصحيحة محمّد بن مسلم في الكافي المتقدّمة.
أو الحمل على التقيّة(4)؛ لأنّه أحد قولي العامّة، وإن كان خلاف المشهور بينهم.
وكيف كان، فإنّ رواية الصدوق قاصرة عن معارضتها بأخبار المشهور.
روى الصدوق رحمه الله في جواز مبادلة الدراهم المغشوشة بالجيّدة، عن يعقوب بن شعيب عندما سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يقرض الدراهم الغلّة المغشوشة فيأخذ منه الدراهم الطازَجيّة الجيّدة، طيّبةً بها نفسه ؟ فقال: «لا بأس»(5).
ويُفهم من كلمة «فيأخذ منه» الشرط بالأخذ.
و قد رفض الشيخ في لنهاية(6)، وأبو الصلاح وجماعة إلى جواز اشتراط الصحيح عن الغلّة، واحتجّ الشيخ بهذا الخبر وغيره.
ص: 283
وذهب ابن إدريس(1) وجماعة من المتأخّرين منهم العلّامة(2) إلى عدم جوازه، واحتجّ بما رواه الكليني عن القمّي، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها، فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط(3).
حيث يدلّ مفهوم الشرط على عدم الجواز مع الشرط، وحمل هذا الخبر على عدم الاشتراط، وهو الظاهر، فيكون مبنى الصدوق موافقاً للكليني.
ما رواه الصدوق في إهلال العمرة المبتولة، وإحلالها ونسكها، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع وطاف بالبيت وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء(4).
فالرواية لم تذكر وجوب طواف النساء، وظاهرها موافق إلى عدم وجوب الطواف في العمرة المفردة، وهو الظاهر من كلام المصنّف.
ولكن على مبنى الكليني رحمه الله وجوب طواف النساء، ولما رواه في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رياح، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ قال: نعم(5).
و نقله الشيخ في الاستبصار(6)، و هو المشهور بل الإجماع على ما نقل في المنتهى.
ص: 284
ويمكن توجيه مبنى الصدوق رحمه الله وجعله موافقاً للكليني فيما قارب بينهما المجلسي بقوله:
لم يذكر فيه التقصير وطواف النساء، لا يدلّ على عدم الوجوب؛ لأنّهما للإحلال وليسا من الأركان، والنسك مع وجودهما في أخبار أُخر والمثبت مقدّم. إلى آخر ما قال...(1).
في هذه المسألة ينقل الصدوق رواية عن الكليني بشأن من مات وعليه دين بقدر ما تركه وله صغار، يقول رحمه الله:
روى محمّد بن يعقوب الكليني رضي اللّٰه عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داوود، عن علي بن حمزه، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك مات وترك صغاراً، وترك شيئاً وعليه دين، وليس يعلم به الغرماء، فإن قضى لغرمائه بقي وُلدُه ليس لهم شيء، فقال: انفقه على وُلدِه(2).
وهذه الرواية موجودة في كتب الكليني(3) والصدوق، وقد عارضاها بروايتين مبثوثة في نفس الباب، وبغضّ النظر عن ضعف هذه الرواية بعلي بن حمزه البطائني الواقفي، عورضت ب:
أوّلاً: ما دلّت عليه رواية ابن البزنطي. فقد ذكر الصدوق رحمه الله في باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال، عن ابن أبي نصر البزنطي بإسناده، أنّه:
سُئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين فينفق عليهم من ماله ؟ قال: إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال(4).
ص: 285
أي الإنفاق من بعد عدم الاستيقان يكون من أصل المال دون الثلث، وقيل بالمعروف من غير إسراف وتقتير.
وقد روى هذه الرواية أيضاً الكليني في الصحيح(1).
ثانياً: ما دلّت عليه رواية ابن الحجّاج، وفيها من المنافاة، والتي عورضت برواية ابن البطائني، فقد روى الصدوق عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا يقول الناس في الوصيّة بالثلث والربع عند موته، أشيء صحيح معروف ؟ أم كيف صنع أبوك ؟ فقال: الثلث ذلك الذي صنع أبي عليه السلام(2).
ورواه الكليني(3) في الصحيح، وفعله عليه السلام ذلك لبيان الجواز، أو الورثة كانوا راضين.
وقال الشيخ رحمه الله في تعليقته على هذه الروايات الثلاث المتقدّمة، بأنّ سند خبر ابن حمزه البطائني:
ضعيف، فلا يجوز العدول إلى هذا الخبر من الخبرين المتقدّمين: البزنطي وابن الحجاج؛ لأنّ خبر عبد الرحمٰن بن الحجّاج موافق للأُصول كلّها، وذلك أنّه لا يصحّ أن ينفق على الورثة إلّاممّا ورثوه، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على مال؛ لأنّ اللّٰه تعالى قال: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ »(4) ، فشرط في صحّة الميراث أن يكون بعد الدين(5).
ومع هذا، فقد أوجد الفقهاء وجه جمع لرواية ابن حمزة البطائني المخالفة للمشهور، وبين قول المشهور، رفعوا به التنافي الوارد في الرواية والمعارضة لكتب الكافي و الفقيه، و من جملة من يتصدّى لرفع التنافي:
ص: 286
أوّلاً: العلّامة التفريشي رحمه الله كما نقله بعض المحقّقين.
فقد أوجد وجهاً حمل به خبر البطائني على خصوص الواقعة، فقال:
لعلّ هذا الحكم محمول على خصوص الواقعة، كأن يكون عليه السلام يعرف الغرماء بأعيانهم، ويعلم أنّ عندهم من الزكاة، فيجعل تلك الديون في زكاتهم، حيث إنّ الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويعلم أنّ عليهم الخمس، فيجعلها في خمسهم من حصّته ويتصدّق هو عليهم، إلى غير ذلك(1).
ثانياً: المحدّث المجلسي رحمه الله.
وقد وجّه رواية البطائني بوجوهٍ أُخرى، منها: ما حكاه المحقّق البحراني:
يمكن حمل الخبر على أنّه عليه السلام كان عالماً بأنّه لا حقّ لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة، أو أنّهم نواصب، فأذن له التصرّف في مالهم، أو على أنّهم كانوا بمعرض الضياع والتلف، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أيّ مالٍ تيسّر(2).
ومن هذا يُعلم بأنّ الأخبار لها وجوه أوّلاً، وأنّ الإمام أعلم بزمانه وأحكامه وما يجري من أحكام طبقاً للوقائع، فتنقل الرواية من دون الواقعة فيشمّ منها التعارض والتنافي أو التزاحم.
وقد أظهر الصدوق رحمه الله هذا المعنى عندما علّق في الفقيه على نصّ لرواية نقلها عن الكافي. قال رحمه الله في الفقيه:
وفي كتاب محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن الميثمي، عن أخويه محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن داوود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية، قال: إنّ رجلاً مات وأوصى إلى رجلين، فقال أحدهما لصاحبه: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف ممّا ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن ذلك:
فقال: ذاك له(3).
ص: 287
فكان تعليقه رحمه الله على الرواية بقوله:
قال مصنّف هذا الكتاب: لست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخطّ الحسن بن علي عليه السلام، ولو صحّ الخبران جميعاً، لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق عليه السلام؛ وذلك لأنّ الأخبار لها وجوه ومعانٍ ، وكلّ إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس، وباللّٰه التوفيق(1).
وهناك الكثير من المباني التي ينظر إليها لأوّل وهله فيحسبها أنّها متعارضة بين مبنى الكليني والصدوق، وقد أوجد الفقهاء وجه جمع بينهما على نحو ما تقدّم، أو على نحو وجه الضرورة أو الكراهة أو الاستحباب أو التقيّة، وغيرها من الوجوه التي تصلح أن تكون وجهاً جامعاً.
والمتحصّل من هذا كلّه: إنّ الصدوق كثيراً ما يعوّل على أحكام توافقية مع الكليني، إمّا بنقل مبنىً ليس له طريق إلّاالكليني، أو مبانٍ أُخرى لها طرق متعدّدة ولكنّها في الأخير تجعل المسلك واحداً من حيث النصوص الموحّدة لفظاً ومعنىً ، أو من حيث المعنى فقط، وكما ظهر هذا في الفصل الأوّل، أمّا الفصل الثاني فالأخبار المتعارضة تعارضها غير مستقرّ، يمكن إيجاد صيغة جمع في توحيد المباني، ومع هذا التوحّد تكون مباني الشيخين لهما من الأثر من حيث الأخذ بها والتقديم على غيرها من المباني عند تعارضهما مع غيرهما، ولذا فقد رجّح الفقهاء عند التعارض ما ينقله الصدوق والكليني رحمه الله عند معارضتهم للأخبار مع غيرهما من الفقهاء، كما يظهر ذلك في أقوالهم:
1 - المحقّق السبزواري رحمه الله:
ذكر في مسألة القضاء عن الميّت من صلاةٍ أو قيامٍ أو دينٍ ، وقام بالأمر أقرب الناس إلى أوليائه، وهو المعروف عند الأصحاب، إلّاأنّه بعد ذلك ينقل رأي لابن أبي عقيل بالمروي عنهم عليهم السلام في بعض الأحاديث:
ص: 288
إنّ من مات وعليه صوم شهر رمضان، تُصُدِّق عنه عن كلّ يوم بمُدٍّ من الطعام.
وبعد ذلك يذكر المحقّق ترجيح أحد القولين، ويذكر أنّه معارض بنقل الصدوق والكليني والترجيح لهما:
إنّها معارضة بنقل الصدوق والكليني... والترجيح لنقلها كما لا يخفى على الناظر في كتب المشايخ الثلاثة، ويمكن حمل الرواية المذكورة على التقيّة(1).
2 - السيّد الخوئي رحمه الله:
قال في تعليقة له على روايات بشأن الصيد البرّي وحرمة أكله، فكان هناك تعارض بين ما نقله الشيخ الطوسي، وبين ما نقله الصدوق والكليني، فقال:
إنّ الصدوق والكليني كلاهما أضبط من الشيخ في النقل، فلا وثوق بنقله، خصوصاً إذا اتّفق الكليني والصدوق على خلافه(2).
وتبقى مباني الفقهاء ومسالكهم وتعدّد آرائهم مجال أخذٍ وردٍّ بينهم، خصوصاً عند المحدَّثين بالفتح والمحدِّثين بالكسر؛ وذلك لاختلاف القراءة للرواية وفهم أبعادها ومداركها والإحاطة بها على نحو الشمول، من جميع جوانبها الفكرية والعلمية والسياسية، لذا بقي علم الفقه والأُصول والحديث تتجاذبه قوّة الدليل من خلال ما ينظره الفقيه ممّا منحه اللّٰه سبحانه من ملكات.
والحمد للّٰه ربّ العالمين، وصلّى اللّٰه على رسوله خاتم النبيّين وعلى آله الطيّبين الطاهرين وصحبه الميامين وسلّم تسليماً.
«وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اَللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ » صدق اللّٰه العليّ العظيم.
ص: 289
1 - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت 460 ه)، طهران: مطبعة خورشيد، الطبعة الرابعة، 1463 ش.
2 - بداية الحجّ ، أحمد بن أحمد الجصّاص، تقريرات السيّد أبو القاسم الخوئي، قمّ : المطبعة العلمية، الطبعة الثانية، 1364 ش.
3 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 595 ه)، بيروت:
دار الفكر للطباعة، 1995 م.
4 - تذكرة الفقهاء، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر الحلّي، قمّ : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأُولى، 1414 ه.
5 - تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت 460 ه)، طهران: مطبعة خورشيد، الطبعة الثالثة، 1364 ش.
6 - جامع أحاديث الشيعة، حسين البروجردي (ت 1380 ه)، قمّ : المطبعة العلمية، الطبعة الأُولى: 1399 ه.
7 - جامع الرواة، محمّد بن علي الغروي الأردبيلي (ت 1101 ه)، مكتبة المحمّدي.
8 - جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية، محمّد بن محمّد النعمان (ت 413 ه)، بيروت:
دار المفيد للطباعة، الطبعة الثانية، 1993 م.
9 - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمّد حسن النجفي الجواهري (ت 1266 ه)، طهران: مطبعة خورشيد، الطبعة الثانية، 1365 ش.
ص: 290
10 - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف بن أحمد البحراني (ت 1186 ه)، قمّ :
مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1416 ه.
11 - الخلاف، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت 460 ه)، قمّ : مؤسّسة النشر الإسلامي، 1407 ه.
12 - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، محمّد بن مكّي العاملي (الشهيد الأوّل) (ت 786 ه)، قمّ : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأُولى، 1419 ه.
13 - رجال النجاشي، أبو العبّاس أحمد بن عليّ النجاشيّ (ت 450 ه)، قمّ : مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1416 ه.
14 - رسائل المرتضى، علي بن الحسين المرتضى (ت 436 ه)، قمّ : مطبعة سيّد الشهداء، 1405 ه.
15 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت 398 ه)، تحقيق أحمد عبد الغفور، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة 1987 م.
16 - علل الشرائع، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه)، النجف الأشرف: منشورات المكتبة الحيدرية، الطبعة الأُولى، 1966 م.
17 - فقه الصادق عليه السلام، محمّد صادق الروحاني، قمّ : مؤسّسة دار الكتاب، الطبعة الثالثة، 1412 ه.
18 - الفهرست، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت 460 ه)، قمّ :
مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولى، 1417 ه.
19 - الكافي، أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329 ه)، طهران: دار الكتب الإسلامية، الطبعة الخامسة، 1363 ش.
20 - الكافي في الفقه، أبو الصلاح الحلبي (ت 374 ه)، إصفهان: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامّة.
21 - كتاب الحجّ (تقريرات السيّد أبو القاسم الخوئي)، محمّد رضا الخلخالي، قمّ : المطبعة
ص: 291
العلمية، الطبعة الثانية، 1364 ش.
22 - كتاب من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه)، قمّ : مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية.
23 - كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام، بهاء الدين محمّد بن الحسن الإصفهاني المعروف بالفاضل الهندي، قمّ : مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولى، 1416 ه.
24 - مختلف الشيعة، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر الحلّي، قمّ : مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1413 ه.
25 - مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، محمّد بن علي العاملي، قمّ : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأُولى، 1410 ه.
26 - مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسيّ (ت 1111 ه).
27 - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين العاملي (الشهيد الثاني)، قمّ : مطبعة بهمن، الطبعة الأُولى، 1413 ه.
28 - مستدركات علم الحديث، علي النمازي الشاهرودي، طهران: مطبعة شفق، الطبعة الأُولى، 1412 ه.
29 - مستند الشيعة في أحكام الشريعة، المولى أحمد بن محمّد مهدي النراقي (ت 1245 ه)، قمّ : مطبعة ستاره، الطبعة الأُولى، 1415 ه.
30 - المستند في شرح العروة الوثقى، مرتضى البروجردي، تقريرات السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي، قمّ : المطبعة العلمية، الطبعة الأُولى 1414 ه.
31 - مصابيح الظلام، بحر العلوم (مخطوط).
32 - معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، أبو القاسم بن عليّ أكبر الخوئي (ت 1413 ه)، الطبعة الخامسة، 1992 م.
33 - المقنع، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق
ص: 292
(ت 381 ه)، إيران: مطبعة اعتماد، 1415 ه.
34 - منتهى المطلب، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر الحلّي، قمّ : مؤسّسة الطبع والنشر في الأستانة الرضوية المقدّسة، الطبعة الأُولى، 1412 ه.
35 - منهاج الصالحين، علي الحسيني السيستاني، قمّ : مطبعة مهر، الطبعة الأُولى، 1414 ه.
36 - منهج المقال (رجال الإسترآبادي)، محمد علي الإسترآبادي (ت 1028 ه).
37 - المهذّب، عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي (ت 481 ه)، قمّ المقدّسة: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، 1406 ه.
38 - نظرات إلى المرجعية، العاملي، بيروت: دار السيرة، الطبعة الأُولى.
39 - النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت 460 ه)، قمّ : انتشارات قدس محمّدي.
40 - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104 ه)، قمّ : مطبعة مهر، الطبعة الثانية، 1414 ه.
ص: 293
ص: 294
د. عبد الإلٰه عبد الوهّاب العرداوي(1)
بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمّد الأمين صلى الله عليه و آله و سلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فإنّ علم الحديث يأتي في مقدّمة العلوم الإسلامية التي وضعها العلماء المسلمون وسيلة من وسائل معرفة الفكر الإسلامي بعامّة، والتشريع بخاصّة.
فعلم الحديث من العلوم الشرعية التي يتوقّف عليها الاجتهاد الفقهي، وتقوم على أساس منها عملية استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، ومن هنا تأتي أهمّية دراسة علم الحديث.
لقد عكف المسلمون وفي مقدّمتهم الشيعة الإمامية على تدوينه وترتيبه في مصنّفات قيّمة، ومن ثمّ نقله إلى الأجيال اللّاحقة، وهم بذلك وضعوا قواعد الشريعة وأضفوا عليها سمة الخلود والدوام.
ومن أجلّ الكتب الحديثية التي جمعت الأحاديث وهذّبتها ورتّبتها على وفق مرويات أهل البيت عليهم السلام الكتب الأربعة المشهورة: الكافي للشيخ الكليني (ت 395 ه)،
ص: 295
وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ت 381 ه)، وتهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ الطوسي (ت 460 ه).
وكتاب الكافي خلاصة آثار الصادقين وعيبة سنّتهم القائمة، فهو كافٍ في علمه، وكافٍ لشيعة آل البيت عليه السلام، ومن هنا تأتي الأهمّية الكبرى لكتاب الكافي بوصفه أحد الموسوعات الحديثية الكبرى للشيعة. أمّا صاحب الكافي الشيخ الكليني فهو من العلماء الأعلام، وسيرته شاعت في الآفاق، وقد نجترء عليه إن لم نمهّد لسيرته وفضله، لكنّ كتب أُخرى ودراسات كثيرة قد أفاضت في ذلك، ولعلّنا بذلك نحيل القارئ إليها(1).
لقد ضمّ كتاب الكافي فضلاً عن مرويات أهل البيت عليهم السلام موضوعات ومحاور شتّى، منها الأشعار التي ذكرها الشيخ الكليني بوصفها شاهداً على ما يريده في مقامات وموارد متعدّدة، فكانت تلك الأشعار سبباً دفعني إلى دراستها للكشف عن كنهها، ومحاولة ربطها مع ما سيقت إليه من موارد في كتاب الكافي، وبذلك تجلّت هذه الدراسة ووُسِمت ب «أشعار الكافي، دراسة تحليلية».
وفي ضوء ذلك اقتضت طبيعة الدراسة أن تُقسّم على مقدّمة وفقرات متسلسلة، حاولنا خلالها توثيق النصوص الشعرية بتخريجها من مظانّها قدر الإمكان، ومن ثمّ تحليلها وربطها مع ما سيقت إليه كشاهد لمواضع مختلفة أوردها الشيخ الكليني كلّاً في مستقرّه. وأخيراً حاولنا استكناه الجوانب الفنّية لتلك الأبيات، وإبراز النكات البلاغية التي جمّلتها وتوسّطت عنقها، وختامها وأوّلها أنّ الحمد للّٰه ربّ العالمين، والعاقبة للمتّقين.
ص: 296
وفيه يسوق لنا الشيخ الكليني أبياتاً هي شواهد لقضايا تتّصل باللغة، ومن ثمّ يحاول الربط بين الدلالة اللغوية والعقائدية، وصولاً إلى موطن الشاهد والدلالة الجامعة لها، ومن الأبيات ما ذكره في باب تأويل الصمد من كتاب التوحيد:
قال أبو طالب في بعض ما كان يمدح به النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من شعره: (من الطويل)
وبالجَمرةِ القُصوى إذا صَمَدوا لها *** يَؤُمُّونَ رَضخاً رأسَها بالجَنادِلِ (1)
وقال بعض شعراء الجاهلية شعراً: (من البسيط)
ما كنتُ أحسبُ أنّ بيتاً ظاهراً *** للّٰهِ في أكنافِ مَكّةَ يُصمَدُ(2)
وقال ابن الزِّبرِقان(3): (من البسيط)
و لا رهيبةَ إلَّا سيّدٌ صمدٌ(4)
وقال شدّاد بن معاوية: (من البسيط)
عَلَوتُهُ بِحُسامٍ ثُمّ قُلتُ لَهُ : *** خُذها حُذَيفُ فأنتَ السَّيِّدُ الصَّمَدُ(5)
والأبيات شواهد على معنى الصمد في اللغة(6)، وهذا المعنى له ماهيّات دلالية
ص: 297
رحبة تصل قريباً من عشرين معنى(1)، ينطلق الشيخ الكليني من خلالها للربط بين المفهوم اللغوي والعقائدي(2) وصولاً إلى إمكان إدخال جميع تلك المعاني في الماهية المركزية العقائدية؛ لاتّصافه جلّ ذكره بجميع الصفات الكمالية، ودلالة على كونه مبدأ لكلّية الصفات.
كما يخلص الشيخ الكليني إلى فساد القول في أنّ تأويل الصمد: هو المصمت الذي لا جوف له(3)، من خلال مناقشته وتعريته من أن يكون صفة للّٰه جلّ ذكره، مستدلّاً بآيٍ من الذكر الحكيم وأخبار الأئمّة عليهم السلام، ولإتمام الفائدة يستدلّ بتلك الأبيات لتأكيد المراد، وبيان معنى الصمد في اللغة.
وتأسيساً على ما قيل، فإنّ اللّٰه عزّ وجلّ هو:
وإليه يلجؤون عند الشدائد، ومنه يرجون الرخاء ودوام النعماء، ليدفع عنهم الشدائد(4).
وفي مقام آخر يورد الشيخ الكليني ما يفرضه التغيير في لفظةٍ ما إلى لفظةٍ أُخرى في البيت من آثار دلالية مختلفة تنقل سياق البيت إلى معانٍ مختلفة وفقاً للقواعد المتعارف عليها في العرف اللغوي. قيل: أنشد الكميت أبا عبد اللّٰه الحسين عليه السلام شعراً:
(من الخفيف)
أخلَصَ اللّٰهُ لي هَوايَ *** فما أُغرِقُ نَزعاً وَ لا تَطيشُ سِهامي(5)
أي جعل اللّٰه محبّتي خالصةً لكم، فصار تأييده تعالى سبباً لأن لا أُخطئ الهدف،
ص: 298
و أُصيب كلّ ما أُريده من مدحكم، وإن لم أُبالغ فيه، وقد استعار مدّ القوس إلى أقصاه ليشير به إلى المبالغة في حبّهم من باب الاستعارة، والمراد بالقوس والسهم المحبّة لهم عليه السلام، وقد علّق الإمام الحسين عليه السلام على البيت بقوله:
لا تقل هكذا: فما أُغرق نزعاً، ولكن قل: فقد أُغرق نزعاً ولا تطيش سهامي(1).
والفرق بين «ما» النافية و «فقد» التحقيقية مع الفعل الماضي جليّ واضح(2).
وغرضه عليه السلام من كلّ شيء مدحه وتحسينه، بأن لا يقصر في مدحنا، بل يبذل جهده فيه.
وفيه يورد أبياتاً تعدّ أدلّة تاريخية وحججاً دامغة يُراد منها رفع التوهّم الذي قد يتحصّل عند بعض المغرضين، أو تكون دليلاً مضافاً إلى حقيقة تاريخية شائعة بين الناس، ومن تلك الأبيات ما ذكره الشيخ الكليني في كتاب الحجّة باب مولد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ووفاته تحديداً، قال أبو طالب: (من الطويل)
ألَم تَعلَموا أَنّا وَجَدنا مُحَمّداً *** نَبيّاً كَموسى في أَوَّلِ الكُتُبِ (3)
وقوله: (من الطويل)
لَقَد عَلِموا أَنَّ ابنَنا لا مُكَذَّبٌ *** لَدَينا وَلا يَعبأُ بِقيلِ الأَباطِلِ
وَأَبيَضُ يُستَسقى الغَمامُ بِوَجهِهِ *** ثِمالُ اليَتامى عِصمةٌ لِلأَرامِلِ (4)
وقد وردت هذه الأبيات شاهداً على من زعم أنّ أبا طالب كان كافراً؟ فكانت الأبيات حججاً دامغة وأدلّة تاريخية ساطعة تبطل تلك المزاعم وتهدّها، تُضاف إلى الحديث المشهور عن أبي عبد اللّٰه الحسين عليه السلام، قال:
ص: 299
إنّ مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسرّوا الإيمان وأظهروا الشرك، فآتاهم اللّٰه أجرهم مرّتين(1).
فموطن الشاهد في الأبيات ملائم لمكان وروده في الكتاب وموضوعه الذي هو «الحجّة».
وفي موضعٍ آخر وفي باب مولد الإمام عليّ بن الحسين عليه السلام، يروي لنا الشيخ الكليني بيتاً لأبي الأسود الدؤلي في الإمام عليّ بن الحسين عليه السلام، هو: (من الطويل)
وَإِنَّ غُلاماً بَينَ كِسرى وَهاشمٍ *** لأََكرَمُ مَن نِيطَت عَلَيهِ التَّمائِمُ (2)
وحجّة البيت أبين من أن نجلو غبارها، فهي الشمس الساطعة في كبد السماء، وصدق ما قيل في الإمام عليّ بن الحسين عليه السلام أنّه: «ابن الخيرتين، فخيرة اللّٰه من العرب هاشم، ومن العجم فارس»(3)، فنوره جمع بين خيرة أهل الأرض من العرب هاشم، ومن العجم فارس، وتحديداً في ابنة يزدجرد آخر ملوك فارس.
وفي مكانٍ آخر يورد هذين البيتين لفاطمة الزهراء عليها السلام: (من البسيط)
قَد كانَ بَعدَكَ أَنباءٌ وَهَنبَثَةٌ *** لَو كُنتَ شاهِدَها لَم يَكثُرِ الخَطبُ (4)
إِنّا فَقدناكَ فَقدَ الأَرضِ وابِلَها *** واختَلَّ قَومُكَ فاشهَدهُم وَلا تَغِب(5)
ص: 300
والبيتان يمثّلان مطالبة الزهراء عليها السلام القوم بعد إخراج أمير المؤمنين عليه السلام من البيعة، أو عند غصب فدك، وقد قالتهما أو تمثّلت بهما بعد فقد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، ولعلّنا نقول لهم من خلال هذين البيتين:
سلهم، أهي عليها السلام صادقة في هذا القول، أم كاذبة ؟ فإن قالوا: كاذبة، فقد كفروا، وإن قالوا: صادقة، فسلهم: ما سبب تلك الهنبثة ؟ ثمّ قل: مَن أضلّه اللّٰه فلا هادي له(1).
ومراده بيّن يتّصل بالقيم الأخلاقية، فكانت الأبيات المستشهد بها بياناً وتأكيداً لتلك القيم. ومنها ما أورده الشيخ الكليني في كتاب الإيمان والكفر باب الاستغناء عن الناس، قال حاتم الطائي: (من الوافر)
إِذا عَزَمتَ اليأسَ أَلفَيتَهُ الغِنى *** إذا عَرَّفتَهُ النَّفسَ ، والطَّمعُ الفَقرُ(2)
فطلب الحوائج من الناس نهب للعزِّ، واليأس منه عزّ المؤمن في دينه، والطمع هو الفقر الحاضر، ولنكن كما قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ليجتمع في قلبك: الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، فيكون الافتقار إليهم في لين كلامك، وحسن بشرك، ويكون حسن استغنائك عنهم في نزاهة عرضك، وبقاء عزّك(3).
فالبيت مصداق من المصاديق لهذا الباب:
ص: 301
وإن لم يذكره للاستشهاد، بل للشهرة والدلالة على أنّ ذلك ممّا يذعن به العاقل وإن لم يكن من أهل الدين(1).
وفي مكانٍ آخر من الكتاب نفسه في باب الكتمان من باب التقيّة حصراً، نرى الشيخ الكليني يستدلّ بقول الشاعر: (من الطويل)
فَلا يَعدونَ سِرّي وَسِرُّك ثالِثاً *** أَلا كُلُّ سِرٍّ جاوَزَ اثنَينِ شائِعٌ (2)
ليكون برهاناً مضافاً لهذا الباب، فاستحالة كتم السرّ لأكثر من اثنين شيوع له وتجاوز لآثاره المترتّبة بفعل الشيوع، ولعلّ المراد باثنين هو الشفتان، وهو أقرب للمعنى وألطف؛ لأنّهما من مخارج التكلّم وأداة من أدواته، وعليه فمن كان على تقية وكتم أمر دينه وولائه لأهل البيت عليهم السلام في الدنيا أعزّه اللّٰه به في الدنيا، وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة، يقوده إلى الجنّة، ومن أذاعه أذلّه اللّٰه به في الدنيا، ونزع النور بين عينيه في الآخرة، وجعله ظلمة تقوده إلى النار، فلا دين من لا تقية له(3).
ومنه ما ورد في كتاب الزكاة باب من أعطى بعد المسألة، قال الشاعر: (من الطويل)
مَتى آتِهِ يَوماً لِأَطلُبَ حاجةً *** رَجَعتُ إِلى أَهلي وَوَجهي بِمائِهِ (4)
فالستر في قضاء الحاجة أحفظ لماء وجه السائل، فالمرء قد يشعر بذلّ السؤال عند قضاء حاجته، والمستتر بها مغفور له، قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم:
المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجّة، والمذيع بالسيّئة مخذول، والمستتر بها مغفور
ص: 302
له(1).
وفيه في هذا الباب قول الشاعر: (من الكامل)
وَإِذا ابتُليتَ بِبَذلِ وَجهِكَ سائِلاً *** فَابذُلهُ لِلمُتَكَرِّمِ المِفضالِ
إِنَّ الكَريمَ إِذا حَباكَ بِوَعدِهِ *** أَعطاكَهُ سَلِساً بِغَيرِ مِطالٍ
وَ إِذا السُّؤالُ مَعَ النَّوالِ قَرَنتَهُ *** رَجَحَ السُّؤالُ وَ خَفَّ كُلُّ نَوالٍ (2)
الذي يقرن فيه قضاء الحاجة وسترها في بكر الحوائج مع عدم ردّ السائل ثانياً؛ لئلّا يقطع شكره على الأوّل، وفي ذلك ردّ السائل ثانياً سحت للنفس وجدب للسخاء.
ومنه أيضاً ما ذكره الشيخ الكليني في كتاب المعيشة باب الدين، قال الشاعر: (من الطويل)
فَإِن يَكُ يا أُمَيمُ عَلَيَّ دَينٌ *** فَعِمرانُ بنُ موسى يَستَدينُ (3)
والبيت في الرواية الأُخرى يرتبط بعتاب يزيد بن طلحة بن عبد اللّٰه جناح في دَينٍ عليه(4)، وعمران بن موسى هذا هو عمران بن موسى بن عبيد اللّٰه، أُمّه أُمّ ولد يقال لها:
جيداء(5)، وقد وهم المصحّح في هامشه(6) في أنّ المقصود من عمران بن موسى هو النبيّ موسى بن عمران عليه السلام، وإنّما قُلب للوزن، وهو شخصية أُخرى كما بيّنا. وفي كلّ
ص: 303
الأحوال فإنّ غلبة الدين على المؤمن انكسار للنفس وضياع لها.
وفيه موارد مختلفة تتعلّق بالحياة الاجتماعية وعلائقها المختلفة، وما تفرزه من قيم وأعراف اجتماعية يعتدّ بها، ويكون لها قصب السبق بما جُبِلَ عليه الإنسان في كونه كائن اجتماعي، ففي كتاب المعيشة باب كسب النائحة يورد لنا الشيخ الكليني قول أُمّ سلمة نادبة ابن عمّها الوليد بن المغيرة: (من مجزوء الكامل)
أَنعى الوَليدَ بنَ الولي *** دِ أَبا الوَليدِ فَتى العَشيرَه
حامي الحَقيقَةِ ماجِدٌ *** يَسمو إلى طَلَبِ الوَتيره
قَد كانَ غَيثاً في السِني *** نَ وَجَعفَراً غَدَقاً وَمِيرَه(1)
فندب الميّت بأحسن أوصافه وأفعاله والبكاء عليه جائز، وقيّد في المشهور جواز نوح النائحة بحقّ ، أي إذا كانت تصف الميّت بما هو فيه من الصفات، فضلاً عن أنّ صوتها لا يسمعها الأجانب(2).
وفيه من كتاب النكاح باب أصناف النساء قول الشاعر: (من الطويل)
أَلا إِنَّ النِّساءَ خُلِقنَ شَتّى *** فَمِنهُنَّ الغَنيمَةُ وَالغَرامُ
وَمِنهُنَّ الهِلالُ إِذا تَجَلّى *** لِصاحِبِهِ وَمِنهُنَّ الظَّلامُ
ص: 304
فَمَن يَظفَر بِصالِحِهِنَّ يَسعَد *** وَمَن يُغبَن فَلَيسَ لَهُ انتِقامُ (1)
الذي يذكر فيه أصنافهنّ ، فمن رام أن يظفر بصالحهنّ كي يتزوّج بها، فلا بدّ أن تُنسب إلى الخير وإلى الخلق القويم، تعين زوجها على دهره ليهنأ في دنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه ليشقى فيهما ويبتلي.
وفيه من كتاب النكاح باب خطب النساء ما قاله عبد اللّٰه بن غنم في خطبة خديجة بنت خويلد، والأبيات أبين عمّا في نفسها، وأشمل في موضوعها ومعناها: (من الطويل)
هَنيئاً مَريئاً يا خَديجَةُ قَد جَرَت *** لَكِ الطَّيرُ فيما كانَ مِنكِ بِأَسعَدِ
تَزَوَّجتِهِ خَيرَ البَريَّةِ كُلِّها *** وَمَن ذا الذي في الناسِ مِثلُ مُحَمَّدِ
وَبَشَّرَ بِهِ البرّانِ عيسى بنُ مَريَمَ *** وَموسى بنُ عِمرانَ فَيا قُربَ مَوعِدِ
أَقَرَّت بِهِ الكُتّابُ قِدماً بِأَنَّهُ *** رَسولٌ مِنَ البَطحاءِ هادٍ وَمُهتَدٍ(2)
وقد تتّصل تلك العلائق الاجتماعية بأُمور تشريعية تترتّب عليها تبعات قضائية، كما هو الحال في البيت الذي تمثّل به الإمام عليّ عليه السلام: (من الرجز)
أَورَدَها سَعدٌ وَسَعدٌ يَشتَمِلُ *** ما هَكَذا تُورَدُ يا سَعدُ الإِبِلُ (3)
والبيت يرتبط بحادثة معلومة سيق من أجلها المثل(4)، فكان تمثّل الإمام عليّ عليه السلام به ملائماً للحادثة التي ذكرها صاحب الكافي(5).
ص: 305
وفيه يتغنّى الشعراء في الحرب بفنون الشعر العربي من فخر ورثاء ومديح، كقول أبي جهل وهو يفتخر بنفسه: (من الرجز)
ما تَنقِمُ الحَربُ الشَّموسُ مِنّي *** بازِلُ عامَينِ حَديثُ السِّنِّ
لِمثلِ هَذا وَلَدَتني أُمّي(1)
أورد الشيخ الكليني هذه الأبيات في موضوعٍ أكرم وأعزّ وأذلّ وقعة عند العرب، والافتخار بالنفس جليّ واضح في هذه الأبيات، فالحرب لا يقدّرها من لا يقدر عليها، فهي بدت كالفرس الشموس التي تمنع أيّ أحد أن يركبها، فاستُعير لها الحرب ذلك من باب الإهلاك والشدّة وعدم أمن أيّ أحد من مكارهها، لكنّه مع ذلك كان مستجمعاً للقوّة كالبازل من الإبل، أي الذي طلع نابه وكملت قوّته.
ونظير هذه الأبيات أبياتاً أُخرى تسمو رفعةً وتعلو شأناً؛ لأنّها صادرة من رجلٍ يبرز سيفه ليجهز عدوّه إلى النار، ومكانته أعلى من أن توصف بأسطرٍ قليلة، قال الإمام عليّ عليه السلام: (من الرجز)
أَنا ابنُ ذي الحَوضَينِ عَبدِ المُطَّلِب *** وَهاشِمِ المُطعِمِ في العامِ السَّغِب
أَوفي بِميعادي وَأَحمي عَن حَسَب(2)
وقد يرتبط البيت بحادثة مؤلمة، كما في بيت ابن أبي عقب الذي تمثل به الإمام الحسين عليه السلام سوسو (من الوافر)
وَيُنحَرُ بِالزَّوراءِ مِنهُم لَدى الضُّحى *** ثَمانونَ أَلفاً مِثلُ ما تُنحَرُ البُدنُ (3)
ص: 306
فهو يشير إلى حادثة الزوراء(1) وما تحمله من مآس وويلات.
وقد يتصل البيت بالرثاء، كما في قول سفيان بن مصعب العبدي وهو يخاطب أم فروة أم الصادق عليه السلام لتبكي على جدها الحسين عليه السلام:
فرو، جودي بدمعك المسكوب(2)
ومن هذا الجانب قول طالب بن أبي طالب: (من الرجز)
يا رَبِّ إِمّا يَغزُوُنَّ بِطالبٍ *** في مِقنَبٍ مِن هَذِهِ المَقانِبِ
في مِقنَبِ المُغالِبِ المُحارِبِ *** بِجَعلِهِ المَسلوبَ غَيرَ السّالِبِ
وَجَعلِهِ المَغلوبَ غَيرَ الغالِبِ (3)
فالأبيات تشير إلى خروج طالب بن أبي طالب مع المشركين في بدر، لكنّ هواه كان مع النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وكان ممّن رجع إلى مكّة، وهذه المعاني نلحظها من خلال ما احتوته الأبيات من نكتة بلاغية، ف «المسلوب والمغلوب» قد يُراد بهما أهل الإسلام
ص: 307
وأهل الشرك، وهو المراد؛ بدليل قول الإمام الحسين عليه السلام في روايةٍ أنّه كان أسلم(1)فطلب من اللّٰه تعالى العزّة والغلبة بأن «يجعل من اختلسه الشيطان غير سالب ومختلس لأهل الإسلام، ويجعل المغلوب بالهوى غير غالب على أهل الإيمان»(2)، ولمّا كان المشركون من أرباب الفصاحة والبلاغة، فهموا مراده، وأنّه كان معنياً بالتورية، فلذلك أمروا بردّه لئلّا يفسد عليهم، كما أشار إليه عليه السلام بقوله: «فقالت قريش: إنّ هذا ليغلبنا فردّوه»(3)؛ خوفاً من أن يلحق بأهل الإسلام ويوقع التفرقة والشقاق بين المشركين.
وفيه تتّصل الأبيات بأحاديث وروايات موضوعة، أو رواة وضّاعون، كما في حديث جارية الزبير، وهو حديث موضوع جدّاً، والواضع أحمد بن هلال الملعون على لسان العسكري عليه السلام، والبيت هو: (من السريع)
إِن عادَتِ العَقرَبُ عُدنا لَها *** وَكانَت النَّعلُ لَها حاضِرَه(4)
والبيت مثل مشهور يُضرب لرجلٍ عرف بالمطل والتسويف(5)، وهو كالحادثة
ص: 308
منبوذ في موقعه تنطلق منه السموم والانحطاط باتّخاذ العقرب والنعل معلمان لها.
وقد يرتبط البيت بحديث لراوية وضّاع، كما في قول كثير عزّة: (من الطويل)
أَلا زَعَمتَ بِالغَيبِ أَلّا أُحِبَّها *** إذا أَنا لَم يُكرَمُ عَلَيَّ كَريمَها(1)
والخبر المتّصل بالبيت في عمومه يدلّ على جلالة الراوية وذمّ دونهما، لكنّه على مصطلح القوم ضعيف، فالإمام الحسين عليه السلام يستشهد ببيتٍ لكثير عزّة يبيّن فيه صدق مودّته لمن أحبّ ، على عكس ما كان يفعلاه حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة من عدم الامتثال لأمره عليه السلام بعدم التعرّض للمفضل بن عمر(2).
ص: 309
1 - الاحتجاج على أهل اللجاج، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت 620 ه)، تحقيق: محمّد باقر الخرسان، دار النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف 1386 ه 1966 م.
2 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد اللّٰه القُرطُبى المالكي (ت 363 ه)، تحقيق:
علي محمّد البجاوي، بيروت: دار الجيل، الطبعة الأُولى، 1412 ه.
3 - أُسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن عزّ الدين عليّ بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت 630 ه)، بيروت: دار الكتاب العربي.
4 - الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي الكناني المعروف بابن حجر العسقلاني (ت 852 ه)، تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي محمّد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأُولى، 1415 ه.
5 - أعيان الشيعة، محسن بن عبد الكريم الأمين الحسينيّ العامليّ الشقرائيّ (ت 1371 ه)، تحقيق: حسن الأمين، بيروت: دار التعارف للمطبوعات.
6 - الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني (ت 356 ه)، شرحه وكتب هوامشه: عبد اللّٰه علي مهنا وسمير جابر، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة، 1422 ه 2002 م.
7 - إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب، الشيخ علي اليزدي الحائري (ت 1333 ه)، تحقيق:
علي عاشور، الكتاب خال من ذكر المطبعة ومكان الطبع وتاريخه.
ص: 310
8 - الأمالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي، تحقيق: الشيخ صلاح بن فتحي والشيخ سيّد بن عبّاس، بيروت: مؤسّسة الكتب الثقافية، 1422 ه 2001 م.
9 - الأمالي، أبو عبد اللّٰه محمّد بن النعمان العُكبَري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت 413 ه)، تحقيق: حسين الأُستاذ ولي وعلي أكبر غفّاري، بيروت: دار المفيد للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1414 ه 1993 م.
10 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (ت 1110 ه)، بيروت: مؤسّسة الوفاء، الطبعة الثانية، 1403 ه 1983 م.
11 - البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 774 ه)، تحقيق: علي شيري، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الاُولى، 1408 ه 1988 م.
12 - تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد مرتضى الزبيدي (ت 1205 ه)، تحقيق: علي شيري، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1414 ه 1994 م.
13 - تاريخ الطبري (تاريخ الأُمم والملوك)، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ الإمامي (ق 5 ه)، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: مؤسّسة الأعلمي.
14 - تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللّٰه المعروف بابن عساكر الدمشقي (ت 571 ه)، تحقيق: علي شيري، بيروت: مطبعة دار الفكر، 1415 ه.
15 - تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي، محمّد على الموحّد الأبطحي (معاصر)، قمّ :
مطبعة سيّد الشهداء، الطبعة الاُولى، 1412 ه.
16 - جامع الرواة، محمّد بن علي الغروي الأردبيلي (ت 1101 ه)، مكتبة المحمّدي (د. ت).
17 - جمهرة أمثال العرب، أبو هلال الحسن بن عبد اللّٰه بن سهل العسكري (ت 395 ه)، تحقيق:
محمّد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، القاهرة: المؤسّسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الاُولى: 1384 ه 1964 م.
18 - دلائل الإمامة، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ الإمامي (ق 5 ه)، قمّ : مركز البعثة للطباعة والنشر، الطبعة الاُولى، 1413 ش.
ص: 311
19 - ديوان ابن ميّادة، جمع وتحقيق: محمّد نايف الدليمي، الموصل: مطبعة الجمهور، 1970 م.
20 - ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق: عبد الكريم الدجيلي، بغداد: شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة، 1373 ه 1954 م.
21 - ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق: الشيخ محمّد حسن آل ياسين، بيروت: دار ومكتبة الهلال، الطبعة الثانية، 1418 ه 1998 م.
22 - ديوان أبي العتّاهية، قدّم له وشرحه: مجيد طرّاد، بيروت: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الاُولى، 1415 ه 1995 م.
23 - ديوان الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام، شرحه: د. علي مهدي زيتون، بيروت: دار الجيل، بيروت، 1416 ه 1995 م.
24 - ديوان حاتم الطائي، شرح وتحقيق: كرم البستاني، بيروت: دار صادر، 1953 م.
25 - ديوان الزبرقان بن بدر، موجود في موسوعة الشعر العربي الإصدار الثالث قرص ليزري، صادر عن المجمع الثقافي 1997 2003 م.
26 - ديوان شيخ الأباطح أبي طالب، جمع: أبي هفان عبد اللّٰه بن أحمد المهزمي (ت 257 ه)، تحقيق واستدراك: الشيخ محمّد باقر المحمودي، قمّ : مطبعة النهضة، الطبعة الاُولى (د. ت).
27 - ديوان كثير عزّة، تحقيق: د - إحسان عبّاس، بيروت: دار الثقافة، 1971 م.
28 - سيرة ابن هشام (السيرة النبويّة)، أبو محمّد عبد الملك بن هشام بن أيّوب الحميري (ت 218 ه)، تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة: مطبعة المدني، 1383 ه 1963 م.
29 - شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار، أبو حنيفة القاضي النعمان بن محمّد المصريّ (ت 363 ه)، تحقيق: محمّد الحسيني الجلالي، قمّ : مطبعة مؤسّسة النشر الإسلامي، (د. ت).
ص: 312
30 - شرح أُصول الكافي، محمّد صالح المازندراني (ت 1081 ه)، تحقيق وتعليق: الميرزا أبو الحسن الشعراني، ضبط وتصحيح: علي عاشور، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الاُولى، 1421 ه 2000 م.
31 - شعر الكميت بن زيد الأسدي، جمع وتقديم: د. داوود سلّوم، بيروت: عالم الكتب للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1417 ه 1997 م.
32 - الصحاح تاج اللغه وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت 398 ه)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة: 1407 ه.
33 - الطبقات الكبرى، محمّد بن سعد الواقدي (ت 230 ه)، بيروت: دار صادر (د. ت).
34 - عشرة شعراء مقلّون، صنعة د. حاتم صالح الضامن، الموصل: دار الحكمة للطباعة والنشر، 1411 ه 1990 م.
35 - العقد الفريد، أبو عمر أحمد بن محمّد بن عبد ربّه (ت 328 ه)، شرحه وضبطه: إبراهيم الأبياري، قدّم له د. عمر عبد السلام تدمري، بيروت: دار الكتاب العربي، (د. ت).
36 - الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق المعروف بالشيخ الكليني (ت 328 ه)، تصحيح وتعليق: علي أكبر غفاري، طهران: مطبعة حيدري، الطبعة الخامسة 1388 ه.
37 - الكامل في التاريخ، عزّ الدين ابن الأثير الجزري (ت 630 ه)، بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، 1386 ه 1966 م.
38 - كشف الغمّة في معرفة الأئمّة، أبو الحسن علي بن عيسى بهاء الدين الأربلي (ت 693 ه)، بيروت: دار الأضواء، الطبعة الثانية، 1405 ه 1985 م.
39 - لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم المعروف بابن منظور (ت 911 ه)، بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، 1374 ه 1955 م.
40 - مجالس ثعلب، أبو العبّاس أحمد بن يحيى ثعلب (ت 291 ه)، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، مصر: دار المعارف، 1948.
41 - مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمّد الميداني (ت 518 ه)، تحقيق: محمّد محيي
ص: 313
الدين عبد الحميد، مصر: مطبعة السعادة، الطبعة الثانية، 1379 ه 1959 م.
42 - مجمع البحرين ومطلع النيرين، الشيخ فخر الدين الطريحي (ت 1085 ه)، تحقيق: أحمد الحسيني، مكتب النشر للثقافة الإسلامية، الطبعة الثانية، 1408 ه.
43 - مدينة المعاجز، هاشم البحراني (ت 1107 ه)، تحقيق: الشيخ عزّة اللّٰه المولائي الهمداني، مطبعة بهمن، الطبعة الاُولى، 1413 ه.
44 - المستقصى في أمثال العرب، أبو القاسم جار اللّٰه محمّد بن عمر الزمخشري (ت 538 ه)، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1408 ه 1987 م.
45 - مناقب آل أبي طالب عليه السلام، ابن شهر آشوب (ت 588 ه)، تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، النجف: المطبعة الحيدرية، 1376 ه 1956 م.
46 - كتاب من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه)، تصحيح وتعليق: علي أكبر غفاري، قمّ : منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقمّ المقدّسة، الطبعة الثانية، 1404 ه.
47 - نسب قريش، عبد اللّٰه المصعب بن عبد اللّٰه الزبيري (ت 236 ه)، اعتنى بنشره: إ. ليفي بروفنسال، مصر: دار المعارف، (د. ت).
48 - الوافي بالوفيات، خليل بن أيبك الصفدي (ت 764 ه)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420 ه 2000 م.
ص: 314
د. مهدي صالح سلطان
لم يحظ كتاب الكافي للكليني - على ما اطّلعت - بعناية المهتمّين باللغة العربية، ولم يُدرس لغوياً كما يستحقّ ، على الرغم من صحّة إسناده ووثاقته وتضمّنه نصوصاً لغويّة مهمّة ترقى إلى مرحلة الاستشهاد اللغوي التي حُدّت بمنتصف المئة الهجرية الثانية. ونصوص الكافي من نصوص البيئة التي نزل بها القرآن الكريم (بيئة قريش)، فضلاً عن انتسابها إلى أفضل من نطق بالضادّ صلى الله عليه و آله، الذي جعل العربية تتقدّم غيرها حتّى صلة الدم، فقد قدّمها صلى الله عليه و آله في النسب إلى أُمّة الإسلام العظيمة.
عن أبي جعفر الصادق عليه السلام قال:
صعد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله المنبر يوم فتح مكّة فقال: أيّها الناس، إنّ اللّٰه قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، ألا إنّكم من آدم عليه السلام وآدم من طين، ألا إنّ خير عباد اللّٰه عبد اتّقاه، إنّ العربية ليست بأبِ والدٍ، ولكنّها لسان ناطق، فمن قصر به عمله لم يبلغهُ حَسَبُهُ ، ألا إنّ كلّ دمٍ كان في الجاهلية أو إحنةٍ فهي تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة(1).
ودراسة النادر والغريب مفرداتاً وتراكيباً وأساليباً، لغةً ومعنىً وإعراباً، إثراء للّغة، وإظهار لأهمّية هذا الكتاب، وإبراز للمعاني الكبيرة التي احتواها.
ص: 315
وكان مدار هذا البحث دراسة النوادر والغرائب المختارة من روضة الكافي للكليني لمجرّد التنبيه على أهمّيته اللغويّة، في أمثلة قليلة تناسب هذا المختصر، من المفردات والتراكيب النادرة والغريبة الكثيرة التي احتواها الجزء الثامن، الجزء الذي عرض النصوص المتنوّعة.
ولابُدّ من الاعتذار عن إدراك المطلوب في مثل هذه البحوث؛ إذ غلب دافع الحرص على المشاركة ضيق الوقت، فيما قصر عن الاستيفاء وتمام التحسين، واللّٰه تعالى نسأل القبول والعفو والعافية.
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام:
وبَثَقا علينا بثقاً في الإسلام لا يُسكَرُ أبداً حتّى يقوم قائمنا، أو يتكلّم متكلّمنا(1).
في البثق معنى الحبس قبل التدقّق، وفي السكَر الحبس والمنع.
وقد أظهر اللغويون المعاني المادّية للمفردتين، في مثل قولهم: بثق السيل الموضع؛ بمعنى خرَقَه وشقّه وفجّره وكسَرَ شطّه، وانبثق: انفجر؛ إذا اندرأ ماؤه من غير أن يُشعر به.
وكسرك شطّ النهر لينبثق الماء، وقد بثقته بثقاً؛ إذا أكّدت انبثاقه.
وسَكرُ النهرِ سدّه، والسَّكرُ: السدّ والحبس(2)، ومنه قوله تعالى: «سُكِّرَتْ أَبْصٰارُنٰا»(3) ؛ أي حُبست وسُدّت عن النظر من الحيرة.
كأنّ الباثقين في نصّ الإمام عليه السلام قد حبسوا الأمر في صدورهما كحبس السدّ الماء، إلى أن جاء زمن البثق والكسر والانفجار، بعد التحمّل وضيق الاحتفاظ وإخفاء البرم.
ص: 316
وجاء بناء الجملة وسبكها ليناسب هذا المعنى، فقد أكّد الفعل «بثق» بمصدره المنصوب، أي المفعول المطلق «بثقاً بثقاً في الإسلام»، ثمّ جاء بما يؤكّد هذا ويدلّ على استمراره، أي نفي سدّه أو إيقافه بنفي سكره «لا يُسكَرُ»، ثمّ بالظرف «أبداً»، ذلك كلّه لإرادة معنى الإحكام في منع السدّ وقصد الضرر وتأسيس ما يحقّق دوام الكسر والانبثاق.
الفعل الماضي «بَثَق» أُسند إلى ألف الاثنين، والجار والمجرور يعود على الفعل «بثق»، وجملة «لا يُسكر» صفة ل «بثقاً»، والفعل «يُسكَرُ» مبني للمجهول، و «أبداً» ظرف زمان منصوب، و «حتّى» لانتهاء الغاية بمعنى «إلى أن»، والفعل المضارع بعدها منصوب ب «أن» مضمرة.
من حديث أبي الحسن موسى عليه السلام:
واحذر أن تكون سبب بليةٍ على الأوصياء، أو حارشاً عليهم بإفشاء ما استودعتُكَ ، وإظهار ما استكتمتُكَ ، ولن تفعل هذا إن شاء اللّٰه(1).
الحرش: الإغراء بين القوم، وحرّش بينهم: أفسد وأغرى وهيّج بعضهم على بعض، وفي الحديث: «أنّه نهى صلى الله عليه و آله عن التحريش بين البهائم»(2)، وذلك ما يكون في التلهّي بإغراء الحيوانات وتهييج بعضها على بعض، كما يُفعل بين الجمال والكباش والديكة، ومن الحرش الخديعة، ومنه ما يُنسب إلى معاوية في الحذر منها في حديث المِسوَر: «ما رأيت رجلاً ينفر من الحرش مثله»(3).
وإحراش الضبّ أن يهيّجه الحارش، فيقعقع الحجارة على رأس جُحره، أو
ص: 317
يحرّك عصاً أو حصىً على قفا جُحره فيحسبه الضبّ دابّة تريد أن تدخل عليه، فيستجيب فيأخذ الحارش بذنبه فيمسكه.
ومن أمثالهم في مخاطبة العالم بالشيء لمن يريد أن يعلّمه: «أتعلّمني بضبٍّ أنا حرشته»(1).
والحارش في وصية الإمام عليه السلام بصيغة اسم الفاعل للدلالة على الثبات، فيمن يتحوّل إلى طرف أهل الجَور وجماعتهم، وقد يزيد على التحوّل بإثارة خصومة من تحوّل إليهم على جماعته الاُولى التي تحوّل عنها.
وقد عُطف «حارشاً» على «سبب بليّة» خبر «أن تكون». ومن معاني «حارش» الذي يثير ويهيّج ويغري ويخدع: الخصم في الانتقام.
من وصية الإمام الصادق عليه السلام في المساكين قوله:
عليكم بحبّ المساكين المسلمين، فإنّه من حقّرهم وتكبّر عليهم، فقد زلّ عن دين اللّٰه واللّٰه له حاقر ماقت، وقد قال أبونا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: أمرني ربّي بحبّ المساكين منهم، واعلموا أنّ من حقّر أحداً من المسلمين ألقى اللّٰه عليه المقت منه والمحقرة حتّى يمقته الناس، واللّٰه له أشدّ مقتاً، فاتّقوا اللّٰه في إخوانكم المسلمين المساكين، فإنّ لهم عليكم حقّاً أن تحبّوهم، فإنّ اللّٰه أمر رسوله صلى الله عليه و آله بحبّهم، فمن لم يحبّ من أمر اللّٰه بحبّه فقد عصى اللّٰه ورسوله، ومن عصى اللّٰه ورسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوين(2).
الحقر: استصغار الشيء، وشيء حقير؛ أي صغير ذليل، وحَقَره واحتقره واستحقره وحقّره تحقيراً: صغّره(3).
ص: 318
والمقت: البغض، قال تعالى: «لَمَقْتُ اَللّٰهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ »(1) .
قال قتادة:
يقول: لمقت اللّٰه إيّاكم - حين دُعيتم إلى الإيمان فلم تؤمنوا في الدنيا - أكبر من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب في الآخرة(2).
وقد قابل بين حبّ المساكين المسلمين، والحقر والمقت، مكرّراً في النصّ صيغ «الحبّ » خمس مرّات، وصيغ «الحقر» أربع مرّات، ومثلها «المقت»، وجاءت هذه الصيغ ضن أربع جمل شرطية متناسبة، هي:
1 - من حقّرهم وتكبّر عليهم، فقد زلّ عن دين اللّٰه.
2 - من حقّر أحداً من المسلمين، ألقى اللّٰه عليه المقت.
3 - من لم يحبّ من أمر اللّٰه بحبّه، فقد عصى اللّٰه ورسوله.
4 - من عصى اللّٰه ورسوله ومات على ذلك، مات وهو من الغاوين.
من خطبةٍ لأمير المؤمنين عليه السلام في ذمّ أهل زمانٍ سيأتي، قوله:
مساجدهم في ذلك الزمان عامرة من الضلالة خربة من الهدى، فقرّاؤها وعمّارها من أخائب خلق اللّٰه وخليقته، من عندهم جرت الضلالة وإليهم تعود...(3).
خيب: أصل يدلّ عدم الفائدة والحرمان، خاب يخيب خيبةً ؛ إذا حرم فلم يفد خيراً(4)، وخيّبه اللّٰه: حرمه، والخيبة: الخسران والحرمان، وخاب سعيه: لم ينل مطلبه، وفي حديث علي عليه السلام: من فاز بكم، فقد فاز بالقدح الأخيب»(5)، أي بالسهم الخائب.
ص: 319
وأخيب وخائب، وجمعها أخائب، مثل أسود أساود وأسفل أسافل، على وزن أفاعل، ومنه ما ورد في القرآن الكريم من هذا الوزن: «أراذلنا» من قوله تعالى: «هُمْ أَرٰاذِلُنٰا بٰادِيَ اَلرَّأْيِ »(1) ، و «أكابر» من قوله تعالى: «جَعَلْنٰا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكٰابِرَ مُجْرِمِيهٰا لِيَمْكُرُوا»(2) ، و «أصابع» من قوله تعالى: «يَجْعَلُونَ أَصٰابِعَهُمْ فِي آذٰانِهِمْ »(3) ، وأنامل من قوله تعالى: «عَضُّوا عَلَيْكُمُ اَلْأَنٰامِلَ مِنَ اَلْغَيْظِ»(4) ... إلخ. وخُيّب: فُعّل.
وقد جانس في النصّ بين المساجد الخربة وأهلها الأخائب؛ إذ المساجد خربة من الهدى على الرغم من ظاهر عمارتها، والأنكى من ذلك كون القائمين عليها من القرّاء والعمّار، لكنّهم من الخُيّب؛ لأنّهم يضلّون ولا يهدون، وضلالهم يعود عليهم.
وجملة «قرّاؤها من أخائب خلق اللّٰه»، مبتدأ خبره شبه الجملة من الجار والمجرور «من أخائب خلق اللّٰه».
ومن خطبة الوسيلة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قوله:
يتلاعنان في دورهما ويتبرّأ كلُّ واحد منهما من صاحبه، يقول لقرينه إذا التقيا:
«يٰا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ اَلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ اَلْقَرِينُ »(5) ، فيجيبه الأشقى على رُثُوثةٍ : ياليتني لم أتّخذك خليلاً، لقد أضللتني(6).
الرثّ : ما يدلّ على خَلَقٍ ، وخِلقان، و متاع البيت الدون، وفي الحديث: «عفوت لك عن الرّثّة»(7)، وأخلاق؛ أي بالية، والخَلَقُ أيضاً: الخسيس البالي من كلّ شيء، ورثّ
ص: 320
الهيأة: قبيحها، ويقال للرجل إذا أثخن في الحرب وبه رمق: قد ارتُثّ فلان، وكلام رثّ : غثّ سخيف، والرثّ من رديء المتاع، وخلقان الثياب، ومنه قول الخنساء حين خطبها دريد بن الصمّة على كبر سنّه: «أتروني تاركة بني عمّي كأنّهم عوالي الرماح، ومرتثّة شيخ بني جُشم ؟»، أرادت أنّه أسنّ ووهن، وقول النعمان بن مقرن يوم نهاوند:
ألا إنّ هؤلاء أخطروا لكم رثّةً وأخطرتم لهم الإسلام(1).
ففي الرثاثة والرثوثة جمع لمعاني، منها: رثّ الهيأة، أو الذي ضُرب في الحرب فأُثخن وحُمل وبه رمق، فإن كان قتيلاً فليس بمرتثّ ، والرثيث الجريح، وفي حديث ابن صوحان: إنّه ارتثّ يوم الجمل وبه رمق، وفي حديث أُمّ سلمة: فرآني مرتثّة، أي ساقطة ضعيفة(2).
فالرثّة من الركّة والضعف والبلى والسقوط والخسّة والرداءة والسخف وسقط المتاع.
وربما أراد النصّ جميع هذه المعاني؛ لأنّها تعبّر عن سوء حال الأشقى الذي هو على رثوثة عند وروده أصعب الموارد، إذ هو يعتقد أنّ صاحبه هذه هو الذي وضعه في موضع الحسرة والندم والخسران.
قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام:
يبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني فتجالسونهم وتحدّثونهم، فيمرّ بكم المارّ فيقول: هؤلاء شرٌّ من هذا، فلول أنّكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون زَبرتموهم ونهيتموهم، كان أبرّ بكم وبي(3).
ص: 321
زَبَر والجمع زُبر، قال تعالى: «آتُونِي زُبَرَ اَلْحَدِيدِ»(1) ، وقوله: «فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً»(2) ، أي قِطعاً. والزبر والتزبير في متداول الكلام وعامية: تحريف عن التأبير الذي هو إصلاح الزرع والنخل، كتشذيب النادّ وقطع الأجزاء الزائدة غير المرغوب ببقائها(3).
الزبر: الزجر والمنع والنهي، وزبره عن الأمر زبراً: نهاه ومنعه ونهره، وماله زبر؛ أي ماله مانع يمنعه من نفسه أو غيره، وهو مجاز؛ لأنّ من زبرته عن الغيّ فقد أحكمته، كزبر البئر بالطي(4).
وما له زَبرٌ: إذا لم تكن له عزيمة تمنعه، وهو مصدر. وزبر الكتاب - فيما يبدو -:
ضبط كتابته ومنع حصول الغلط فيه، وفي الزبر معنى الكتابة والانتهار والمنع، والزبور كتاب داوود عليه السلام.
وفي الحديث: إذا رددت على السائل ثلاثاً فلا عليك أن تزبره»؛ أي تنتهره وتغلظ له في القول والردّ(5).
وجملة «لو» في نصّ الإمام عليه السلام شرطية عقدت سببية ومسببّية بين «بلغكم ما تكرهون»، و «زبرتموهم ونهيتموهم»، وقد اُتبعت «لو» بأداة شرطية ثانية، هي «إذا»، «لو أنّكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون، زبرتموهم ونهيتموهم»، وجواب الشرط «زبرتموهم»، عطف عليه «نهيتموهم».
من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام قوله:
ص: 322
فرحم اللّٰه امرأً راقب ربّه، وتنكّب ذنبه، وكابر هواه، وكذّب مُناه، امرأً زمّ نفسه بزمام، وألجمها من خشية ربّها بلجام(1).
زمّ يدلّ على استقامة وقصد، وأمر فلان زمم؛ أي قصد، ويحلفون فيقولون: «لا والذي وجهي زمَمَ بيته»؛ يريدون تلقاءه وقصده، والزمّ التقدّم في السير(2).
والزمّ : مصدر زممت البعير؛ أي علقت عليه الزمام(3).
وقد يسمّى المقود زماماً، والزمام الخيط الذي يُشدّ به، وزمّ البعير: خطمه، وزمام البعير وزمام النعل وما يشدّ به الشسع(4)، والذئب يأخذ السخلة فيذهب بها زامّاً رأسه؛ أي رافعاً، وقد ازدمّ سخلة؛ أي ذهب بها(5).
زمّ البعير بأنفه: رفع رأسه لألم، وزمّ فلان بأنفه أو برأسه: رفع رأسه كبراً، وشمخ وهو زامّ ، وهم زُمَّم، وازدمّ إليه: مدّه إليه، وهو على زمام: على شرف من قضائه(6).
الزمام في النصّ معنوي ذهني، إذ هو من التقوى، وقد انتزع من الاستعمال المادّي، إذ صار دالاًّ في النصّ على الاستقامة والتوجّه والقصد والرفع.
إذ زمّ نفسه: قادها وتمكّن منها وصانها ورفعها عمّا يخفضها ويدنيها؛ لأنّ زمامها هنا من التقوى.
«زمّ » الفعل الماضي، تعدّى بنفسه وبالجارّ «من» مرّة و «الباء» مرّة أُخرى، وفاعله مضمر، و «نفسه» المفعول به، و «من التقوى» جارّ ومجرور متعلّق بزمّ ، و «بزمام» المجرور من لفظ «زمّ »، لكنّه جُرّ بالباء الدالّ على الاستعانة.
ص: 323
من وصية للإمام الصادق عليه السلام في التحمّل والامتناع عن السبّ ، قوله:
إيّاكم وسبَّ أعداء اللّٰه؛ حيث يسمعونكم فيسبّوا اللّٰه عدواً بغير علم، وقد ينبغي لكم أن تعلموا حدّ سبّهم للّٰه كيف هو؟ أنّه من سبّ أولياء اللّٰه فقد انتهك سبّ اللّٰه، ومن أظلم عند اللّٰه ممّن استَسبّ للّٰه ولأولياء اللّٰه...(1).
السبّ : الشتم والقطع والطعن، والتسابّ : التشاتم والتقاطع، وتسابّا: تقاطعاً، ورجل سُبّة: يسبّه الناس كثيراً، وسُبَبَة: يسبّ الناس كثيراً(2)، واستُبّوا: إذا سبّ بعضهم بعضاً، واستسبّ : طلب المسبّة وبادر إليها. وفي الحديث:
سباب المسلم فُسوق»، ومنه أيضاً: «لا تَدعُ والدك باسمه، ولا تستسبّ له، أي لا تعرّضه للسبّ وتجرّه إليه، بأن تسبّ أبا غيرك فيُسبّ أباك مجازاةً لك(3).
وبينهم أُسبوبة وأسابيب يتسابّون بها؛ أي شيء يتشاتمون به(4).
وصيّة الإمام عليه السلام بالامتناع عن طلب المسبّة والمبادرة إلى مسابّة أعداء اللّٰه، ومن يبادر ويُسمِع أعداء اللّٰه المسبّة، فلا أظلم منه.
وفي القرآن الكريم: «وَ لاٰ تَسُبُّوا اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ فَيَسُبُّوا اَللّٰهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ زَيَّنّٰا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ »(5) . والآية تريد الارتفاع بالآداب في المجتمع ومنع تحكّم العصبيّة للرأي بالانزلاق إلى التسابّ بذكر القبيح الشنيع للإهانة(6)؛ لأنّ الإنسان مجبول للدفاع عمّا يعتقد، ففي الآية صون كرامة مقدّسات المجتمع الديني من أن يندفع المخالف في ردّ المسبّة، والمنع عامّ فيها، إذ
ص: 324
جاء بنفي المسبّة «وَ لاٰ تَسُبُّوا» ، أمّا في الوصيّة فالتشديد على من يتمادى بأن يطلب المسبّة ويبادر إليها، وأُريد ب «من» الاستفهامية معنى النفي، أي ليس هناك أظلم ممّن استسبّ للّٰه ولأوليائه.
من حديث أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام لأصحابه عن ضرر أهل الباطل ودفع عناية اللّٰه، قوله:
فإذا ابتُليتم بذلك منهم، فإنّهم سيؤذونكم، وتعرفون في وجوههم المنكر، ولولا أنّ اللّٰه تعالى يدفعهم عنكم لَسَطَوا بكم(1).
سطا يسطو؛ إذا قهر، والسطو: القهر بالبطش، ويسطو على فلان: يتطاول عليه، وأمير ذو سطوة: ذو شتم وظلم وضرب، والسطوة: الاستعلاء وشدّة البطش، وسطا الراعي على الشاة؛ إذا مات ولدها في بطنها فسطا عليها فأخرجه(2).
قال تعالى: «وَ إِذٰا تُتْلىٰ عَلَيْهِمْ آيٰاتُنٰا بَيِّنٰاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلْمُنْكَرَ يَكٰادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيٰاتِنٰا»(3) ، أي إظهار الحالة الهائلة للإخافة والتهديد بالبطش من شدّة الغيظ(4).
الوصية أفادت من المفردة القرآنية «يسطون»، لكنّ أُسلوب الإيراد مختلف، ففي الوصية جاء الموصي عليه السلام ب «لولا» الامتناعية المتبوعة بأنّ المصدريّة وجوابها مقترن باللّام، ومثل هذا ما جاء في القرآن الكريم، في قوله تعالى: «فَلَوْ لاٰ أَنَّهُ كٰانَ مِنَ اَلْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ »(5) .
ص: 325
«ولولا أنّ اللّٰه تعالى يدفعهم عنكم لسطوا بكم»، وتقدير المصدر المؤوّل من أنّ ومعموليها بمصدر صريح، أي: لولا أنّ اللّٰه تعالى يدفعهم؛ لولا دفع اللّٰه تعالى، فالمعنى: امتنع بطش أهل الباطل؛ لدفع اللّٰه، فلولا دفع اللّٰه موجود لبطش أهل الباطل بكم.
من خطبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن بويع بعد مقتل عثمان، قوله:
ألا وإنّ بليّتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اللّٰه نبيّه صلى الله عليه و آله، والذي بعثه بالحقّ لتُبَلبَلُنّ بَلبَلةً ولتُغربَلُنّ غربلةً ، ولتُساطُنّ سَوطَةَ القِدر حتّى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وليسبقنّ سابقون كانوا قصروا، وليقصرنّ سابقون كانوا سبقوا(1).
السوط يدلّ على مخالطة الشيء بالشيء، يقال: سطت الشيء؛ خلطت بعضه ببعض، وسوّط فلان أمره تسويطاً؛ إذا خلطه(2).
وساط وسوّط واستوط أمره: اختلط، وساط الهريسة وسوّطها: حرّكها بخشبة، وهو يسوّط الأمر سوطاً؛ يقلّبه ظهراً لبطن، وفلان يسوط الحرب ويسوّطها؛ أي يباشرها.
وفي حديث علي عليه السلام عن فاطمة عليها السلام: «مسوط لحمها بدمي ولحمي»؛ أي ممزوج ومخلوط.
ومن بردة قول كعب بن زهير:
لكنّها خُلّة قد سيط من دمها *** فجعٌ وولعٌ وإخلافٌ وتبديلُ
أي كأنّ هذه الأخلاق قد خلطت بدمها، كالتسويط(3).
ص: 326
أكّد أمير المؤمنين عليه السلام جملة «لتساطُنّ سوطة القدر» بالنون الثقيلة، ثمّ بمصدر الفعل المبيّن لنوع السوط، كلّ ذلك للتنبيه على الفتنة التي فتنوا بها والحالة التي صاروا إليها.
واللّام لام الطلب يجزم به الفعل المضارع، لكنّ الجزم لم يظهر؛ لإسناد الفعل إلى واو الجمع التي اختفت ولم يبق منها إلّاالضمّة لتوكيد الفعل بالنون الثقيلة، والأصل:
لتساطوا + \نّ \لتُساطُنَّ ، فالضمّة ما بقي من واو الفاعل المحذوفة.
من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في بيان نهاية الظالمين، قوله:
فلما بلغوا المدّة، واستتمّوا الأُكلة، أخذهم اللّٰه عز و جل واصطلمهم(1).
صلم: يدلّ على قطع واستئصال، يقال: صلم أُذنه؛ إذا قطعها واستأصلها، والصيلم: الداهية والأمر العظيم، وكأنّه سُمّي بذلك لأنّه يصطلم، والاصطلام:
الاستئصال، والاصطلام: إبادة قوم من أصلهم إذ يقال: اصطلموا(2).
وصلم الشيء صلماً: قطعه من أصله، وقيل: الصلم: قطع الأُذن والأنف من أصلهما، واصطلم القوم: أُبيدوا من أصلهم. وفي حديث الفتن: «وتصطلمون في الثالثة»، والاصطلام بوزن افتعال من الصلم القطع، وحديث عاتكة: «لئن عدتم ليصطلمنّكم»(3).
«لمّا» في النصّ اقتضت جملتين، وقد وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما(4)، وقد اختُصّت بالماضي: «لمّا بلغوا المُدّة واستتمّوا الأُكلة» (الجملة الاُولى)،
ص: 327
«أخذهم اللّٰه عز و جل واصطلمهم» (الجملة الثانية)، ف «لمّا» حرف وجود لوجود، أو وجوب لوجوب، و «لمّا» بمعنى حين، وعند ابن مالك بمعنى «إذ»، وقد حسّن ابن هشام هذا الرأي؛ لأنّها مختصّة بالماضي(1)، ومثل هذه الجملة قوله تعالى: «فَلَمّٰا نَجّٰاكُمْ إِلَى اَلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ »(2) .
وقد ربطت «لما» الحينية في النصّ بين تمام الأُكلة، وأخذ اللّٰه واصطلامه، أي:
حين بلغوا كمال المتعة واللّذة، حان موعد القطع والاستئصال؛ ليكون ذلك أشدّ إيلاماً وأوضح عبرة لمن لم ينتهِ من المستكبرين.
من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في إيضاح اختلاط الأُمور على من لم يبحث عن الحقّ وأهله ليلزمه، ويعرف الباطل ليتجنّبه ويتجنّب أهله، قوله:
إنّ الحقّ لو خَلَصَ لم يكن اختلاف، ولو أنّ الباطل خَلَصَ لم يُخَف على ذي حِجىً ، لكنّه يأخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث، فيمزجان فيجلّلان معاً، فهناك يستولي الشيطان على أوليائه(3).
ضغث: أصل يدلّ على التباس الشيء بعضه ببعض، يقال للحالم: أضغث الرؤيا، والأضغاث: الأحلام الملتبسة(4).
فإذا التبست الأحلام بعضها ببعض فلا تتميّز مخارجها ولا يستقيم تأويلها، فهي إذ ذاك أضغاث أحلام، والضغث من الخبر والأمر: ما كان مختلطاً لا حقيقة له(5).
وأصل الضغث: القُبضة والحُزمة والقُمش، أي ملء الكفّ ، وكلّ مقبوض بجُمع
ص: 328
الكفّ ضغث، والضغث قبضة من قضبان أو حشيش، أو كلّ ما ملأ اليد، وفي التنزيل العزيز: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاٰ تَحْنَثْ »(1) ، يقال إنّ أيّوب عليه السلام أخذ حزمة من أسل ضرب بها امرأته ضربة واحدة، فخرج من يمينه(2).
عبّر أمير المؤمنين عليه السلام عن أنّ مدخل الشيطان واستيلاءه على أوليائه اختلاط الأُمور؛ ذلك لغموض الأُمور على غير المدقّق، فلا خلوص للحقّ من الباطل؛ لأنّه «يأخذ من هذا ضغث، ومن هذا ضغث». والجملة فعلية، أُسند فعلها المضارع «يأخذ» إلى «ضغث»، وعطف عليه مثله، ولم يكتفِ بالأخذ من هذا ومن هذا، بل ذكر الخلط بينهما في قوله: «فيمزجان» ثمّ يغطّيان، في قوله: «فيجلّلان»، للاختبار بالإلباس والإغراء.
واختار ضغث ولم يختر قبضة التي بمعناها؛ لأنّه أراد معنيي ضغث؛ لأنّه أراد فضلاً عن القبضة الاختلاط والامتزاج التي تتضمّنها ضغث، ثمّ ذكر الاختلاط والامتزاج أنفسهما.
من خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين عليه السلام في ذكر عاقبة الظالمين، قوله:
وعن قليل ستعلمون ما توعدون، وهل هي إلّاكلعقة الآكل، ومذقة الشارب، وخفقة الوسنان، ثمّ تلزمهم المعرّات خزياً في الدنيا ويوم القيامة يُردّون إلى أشدّ العذاب، وما اللّٰه بغافلٍ عمّا يعملون(3).
العَرُّ والعُرُّ: الجرب والقذارة، وجملٌ أعرُّ: أجرب، وناقة عراء، ونحّ الجرباء عن العارّة؛ فالجرباء التي عمّها الجرب، والعارّة التي بدأ فيها ذلك، ورجل عارورة أي
ص: 329
قاذورة، وعرّ فلان قومه بشرّ إذا لطخهم به وأعداهم، وأدخل عليهم مكروهاً، وعرّه:
ساءه، والعرير: الغريب، ومن ذلك حديث حاطب بن بلتعة حين قيل له: لِمَ كاتبت أهل المدينة ؟ فقال: «كنت عريراً فيهم»؛ أي غريباً لا ظهر لي.
والمعرّة بوزن مفعلة: موضع العرّ أي الجرب، والمعرّة أيضاً: الشدّة والمساءة والأذى، قال تعالى: «فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ »(1) ، أي إثم وجناية، صان اللّٰه المؤمنين عنها، والعرّة: الخُلّة القبيحة، ومعرّة الجيش: وطأتهم وأذاهم وضررهم(2).
جاء النصّ بجملة: «تلزمهم المعرّات»، فأسند فعل الملازمة «تلزمهم» إلى صيغة جمع المعرّة؛ لمناسبة التشديد عليهم، فليست معرّة واحدة بل معرّات، ولن تفارقهم، أي اجتمعت في العقاب الذي تضمّنته صيغة المعرّات معاني فيها الإضرار الملازمة التي هي من مثل: الجرب، والقذارة، وعموم الأذى، والشدائد، لما يستحقّون.
أنشد الكميت أبا عبد اللّٰه الصادق عليه السلام شعراً، فقال:
أخلص اللّٰه لي هواي فما *** أغرق نزعاً ولا تطيش سهامي
فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام:
لا تقل هكذا: فما أغرق نزعاً، ولكن قل: فقد أغرق نزعاً ولا تطيش سهامي(3).
وقد صحّح الإمام عليه السلام ما وقع فيه الشاعر من غلط لغوي إذ غيّر أُسلوب الجملة من النفي إلى الإثبات، وسيتّضح ممّا سنذكر من تدقيق دلالة جملة الشاعر، وتصحيحها الذي جاء به الإمام عليه السلام:
ص: 330
نَزَعَ في القوس ينزِع نزعاً إذا مدّ وترها، قال تعالى: «وَ اَلنّٰازِعٰاتِ غَرْقاً»(1) ، قال الفرّاء: تنزع الأنفس من صدور الكفّار، ويُغرِقُ النازع في القوس إذا جذب الوتر، وأغرق النازع في القوس أي استوفى مدّها، والإغراق في النزع: أن ينزِع حتّى يشرِب بالرصاف أي (الالتصاق والإحكام)، وينتهي النزع إلى كبد القوس كلّه إلى الحديدة، يضرب مثلاً للغلوّ والإفراط، ويقال غرّق النبل: إذا بلغ به غاية المدّ في القوس(2).
المِنزَع: السهم، والنَّزَعة: الرماة، ومنه المثل: عاد الرّميُ على النَّزَعةِ ، للذي يحيق به مكره(3).
يتّضح ممّا سبق أنّ الشاعر كان يريد إثبات النزع، لكنّه توهّم فجاء بالنفي، لهذا صحّح له الإمام عليه السلام، أي أراد الشاعر تحقيق الرمي لا نفيه، بدليل قوله: لا تطيش سهامي، أي يرمي ويصيب هدفه فلا تطيش سهامه، والنفي لا يؤدّي هذا المعنى، فإن امتنع عن النزع فلا سهام تنطلق من قوسه.
عن أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام:
ألا ومن عرف حقّنا، أو رجا الثواب بنا، ورضي بقوته نصف مدّ كلّ يوم، وما يستر به عورته، وما أكنّ به رأسه(4).
كنّ : يدلّ على ستر أو صون، وكننت الشيء في كنّه: إذا جعلته فيه وصنته، وأكننت الشيء: أخفيته، والكنانة كالجعبة: موضع حفظ الأقواس، وهي القياس(5).
ص: 331
والكنّ : السترة، والجمع أكنان، قال تعالى: «جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْجِبٰالِ أَكْنٰاناً»(1) ، والأكنّة:
الأغطية، قال تعالى: «وَ جَعَلْنٰا عَلىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً »(2) ، وكنّ الشيء: ستره وصانه من الشمس، وأكنّه في نفسه: أسرّه، وقال أبو زيد «كنّه» و «أكنّه» بمعنىً واحد في الكنّ وفي النفس جميعاً، واكتنّ واستكنّ : استتر(3).
الكِنُّ : كلّ شيء وقى شيئاً، فهو كنّه وكنانه، والفعل من ذلك: كننت الشيء، أي جعلته في كنّ ، وأكنّه كنّاً، قال تعالى: «أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ »(4) ، أي أخفيتم وسترتم.
واكتنّت المرأة؛ إذا سترت وجهها حياءً من الناس(5).
عرض النصّ منهج الإمام عليه السلام في القناعة بالقليل، وهو يحثّ أتباعه عليه، ذلك منهج الكفاف الذي يرتضي بالقليل من القوت، وستر العورة، وربّما يغطّي الرأس التغطية المعروفة، أو ربّما أراد إخفاء الشخصيّة عمّن يحسن إليه، كما يدلّ الكلام السابق، وقد نوّع صيغ الفعل الذي استعمله، إذ استعمل الماضي المجرّد «رَضِيَ »، والمضارع «يستُرُ»، والماضي المزيد «أكنّ ».
من رسالة أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام التي تضمّنت وصاياه إلى أصحابه في تجنّب شرّ أهل الباطل المفروضين عليهم، في قوله:
ص: 332
عليكم بمجاملة أهل الباطل، وتحمّلوا الضيم منهم، وإيّاكم ومماظّتهم(1).
مظّ: تدلّ على مُشارّة ومنازعة، وماظظته مماظّة ومظاظاً: خاصمته وشاررته ونازعته، وفي الحديث:
لا تماظّ جارك؛ فإنّه يبقى ويذهب الناس»(2).
والمُشارَّة: المخاصمة والمعاداة، وفيه معنى التفاعل من الشرّ، وفي الحديث: «لا تُشارّ أخاك»، أي لا تفعل به شرّاً فتحوجه إلى أن يفعل بك مثله، وفي حديث أبي الأسود: «ما فعل الذي كانت امرأته تُشاره وتُماره»(3).
والمماظظة: شدّة الخلق وفظاظته، ولا يكون ذلك إلّامقابلة من طرفين، قال أبو عبيدة:
المماظّة: المخاصمة والمشاقّة والمشارّة وشدّة المنازعة مع طول اللزوم، وماظظت الخصم؛ أي لازمته، وتماظّوا: تعاضّوا بألسنتهم، والمماظّة أيضاً المشاتمة، أمظّ:
شتم، وتماظّ القوم: تشاتموا(4).
وجّه النصّ إلى النهي عن منازعة أهل الباطل ومخاصمتهم ومشاتمتهم، والترادّ معهم ومقابلتهم بمثل خصومتهم.
استعمل أُسلوب التحذير بحذف الفعل، إذ الجملة مؤلّفة من ضمير نصب المخاطبين «إيّاكم» الواقع موقع المفعول به، بفعل التحذير المحذوف وتقديره «أُحذّر» والمحذّر منه «مماظّتهم» المنصوب وجوباً.
من خطبة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعدما بويع بعد مقتل عثمان، قال:
واللّٰه ما كتمت وشمةً ، ولا كذبت كذبةً (5).
وشمّ يده؛ أي غرزها بالإبرة ثمّ ذرّ عليها النؤر وهو النيلج، والنؤر: دخّان الشحم،
ص: 333
أو يُحشى الغرز بالكحل فيخضرّ.
والاسم الوشم، وجمعه وشام، وشمت الواشمة تشِمُ وشماً، والموشومة والمستوشمة: التي تسأل أن تشم.
ومن أمثالهم: «لهو أخيل في نفسه من الواشمة».
وقد أوشمت السماء: إذ بدا منها برق، وأوشم النبت؛ إذا أبصرتَ أوّله، وأوشمت الأرض؛ إذا ظهر شيء من نباتها.
وما عصتك وشمة؛ أي طرفة عين، وأوشم فلان في ذلك الأمر إيشاماً؛ إذا نظر فيه، وأوشمت الأعناب؛ إذا لانت وطابت.
وقال ابن شميل: «الوشوم العلامات»(1).
أقسم الإمام عليه السلام بقوله: «واللّٰه ما كتمت وشمة»، أي أنّه كان صريحاً ناصحاً صادقاً لم يكتم شيئاً، ولا كذب كذبة، ولا أخفى علامة، ولا طرفة عين.
وفي «وشمة» عدّة معاني: العلامة من الوشم، مثلما ذكر أهل اللغة، ومنه ما هو أصل الوشم المعروف، أي نقش وزينة على اليد والوجه وبقية أجزاء الجسم، ومنه ما نُقل إلى معانٍ أُخرى، كوشم السماء برقها، ووشم النبت أوائله، وأوشمت الأرض أنبتت نباتها، وهكذا.
قال أبو عبد اللّٰه الصادق عليه السلام:
كيف صنعتم بعمّي زيد؟ قال [سليمان بن خالد]: إنّهم كانوا يحرسونه، فلمّا شفّ الناس أخذنا جثّته فدفنّاه في جرف على شاطئ الفرات، فلمّا أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه، قال [الإمام عليه السلام]: أفلا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات ؟...(2).
ص: 334
وَقَرَ: أصل يدلّ على ثقل في الشيء، وأوقر بعيره: من الوِقر، وأوقرتِ النخلة؛ أي كثر حملها، يقال: نخلة موقرة، والوقر: الثقل يُحمل على ظهرٍ أو على رأس، وامرأة موقرة: إذا حملت حملاً ثقيلاً، قال تعالى: «فَالْحٰامِلاٰتِ وِقْراً»(1) ، يعني السحاب تحمل الماء الذي أوقرها، وقوله تعالى: «وَ فِي آذٰانِنٰا وَقْرٌ»(2) .
أوقر الدابّة إبقاراً وقرة، ودابّة وقرى، وأكثر ما يُستعمل الوقر في حمل البغل والحمار، والوسق في حمل البعير، وفي الحديث: «لعلّه أوقر راحلته ذهباً»، أي حمّلها وقراً(3).
عبارة الإمام عليه السلام: «ألا أوقرتموه»، فيها معنى التوبيخ والإنكار لعدم تحسّبهم لعودة الذين مثّلوا بالشهيد أن يعودوا ويواصلوا أفعالهم الشنيعة، فكان عليهم - على رأي الإمام - أن يدبّروا التدبير الصحيح الكامل، وهو إلقاء الجثمان في الفرات بعد توقيره بالحديد؛ لكي لا يطفو ويظهرُ لقَتَلَته على سطح الماء مرّة أُخرى.
1 - من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في ردّ من طلب التفضيل وعدم الحكم بما أمر اللّٰه:
أما وإنّي أعلم الذي تريدون ويقيم أودكُم، ولكن لا أشتري صلاحكم بفساد نفسي(4).
يقيم أودكم: يستميلكم بتعديل ما اعوجّ منكم.
2 - قول أبي طالب عليه السلام يستحثّ أبا لهب لنصرة ابن أخيه صلى الله عليه و آله حين أراد المشركون قتله: «إنّ امرأً عمّه عينه في القوم ليس بذليل»(5) في «عمّه عينه» جناس رائع.
ص: 335
3 - عن أحد أصحاب الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام بعد خروج خصوم الإمام منه وهم يقولون: إمامنا أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمّد بعد أن كانوا يناوئونه ويعادونه:
قوله: «ما كان أقرب رضاهم من سخطهم»(1).
4 - خاطب أحدهم أمير المؤمنين عليه السلام من ضمن كلام طويل، بقوله: «كنت شاهدَ من غاب منّا، وخلفَ أهل البيت لنا، وكنت عزّ ضعفائنا، وثمال فقرائنا، وعماد عظمائنا، يجمعنا في الأُمور عدلُك، ويتّسع لنا في الحقّ تأتّيك»(2).
5 - عن أبي جعفر الباقر عليه السلام:
إنّ إبراهيم عليه السلام خرج ذات يوم يسير... فمرّ بفلاة من الأرض فإذا هو برجل قائم يصلّي... فقال له إبراهيم عليه السلام لمن تصلّي ؟ قال: لإلٰه إبراهيم فقال له ومن إلٰه إبراهيم فقال الذي خلقك وخلقني، فقال إبراهيم عليه السلام: قد أعجبني نحوك وأنا أحب أن أواخيك في اللّٰه...(3).
وعبارة أعجبني نحوك، وهذا النحو، ارتبطت بأمير المؤمنين عليه السلام وأبي الأسود الدؤلي وعلم النحو. فعن أبي الأسود الدؤلي، قوله:
كنت كلّما وضعت باباً من أبواب النحو عرضته عليه [يعني أمير المؤمنين عليه السلام] إلى أن حصلت ما فيه الغاية، قال: ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت، فلذلك سُمّي النحو(4).
أو قول علي عليه السلام: «انح هذا النحو»(5).
ص: 336
* القرآن الكريم.
1. الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي، تحقيق:
د. مازن المبارك، بيروت، الطبعة الثانية، 1973 م.
2. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت 1205 ه)، تحقيق: مجموعة من الأساتذة، الكويت.
3. تفسير الميزان (الميزان في تفسير القرآن)، محمّد حسين الطباطبائيّ (1402 ه)، قمّ : طبع مؤسّسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1394 ه.
4. ديوان الأدب في اللغة، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي الحنفي (ت 350 ه)، القاهرة: مجمع اللغة العربية، 1979 م.
5. الكافي، أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329 ه)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، طهران: دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثانية، 1389 ه.
6. لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور المصري (ت 711 ه)، قمّ : نشر أدب الحوزة.
7. مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548 ه.)، تحقيق:
السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي والسيّد فضل اللّٰه اليزدي الطباطبائي، بيروت: دار المعرفة، الطبعة الثانية، 1408 ه.
ص: 337
8. مختار الصحاح، الإمام محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، بيروت: دار الكتاب، 1981 م.
9. معجم الأفعال المتعدّية، موسى بن محمّد بن الملياني الأحمدي، بيروت: دار العلم، 1979 م.
10. مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب، أبو محمّد عبد اللّٰه جمال الدين بن يوسف الأنصاري المصري المعروف بابن هشام (ت 761 ه)،
ص: 338
الصورة
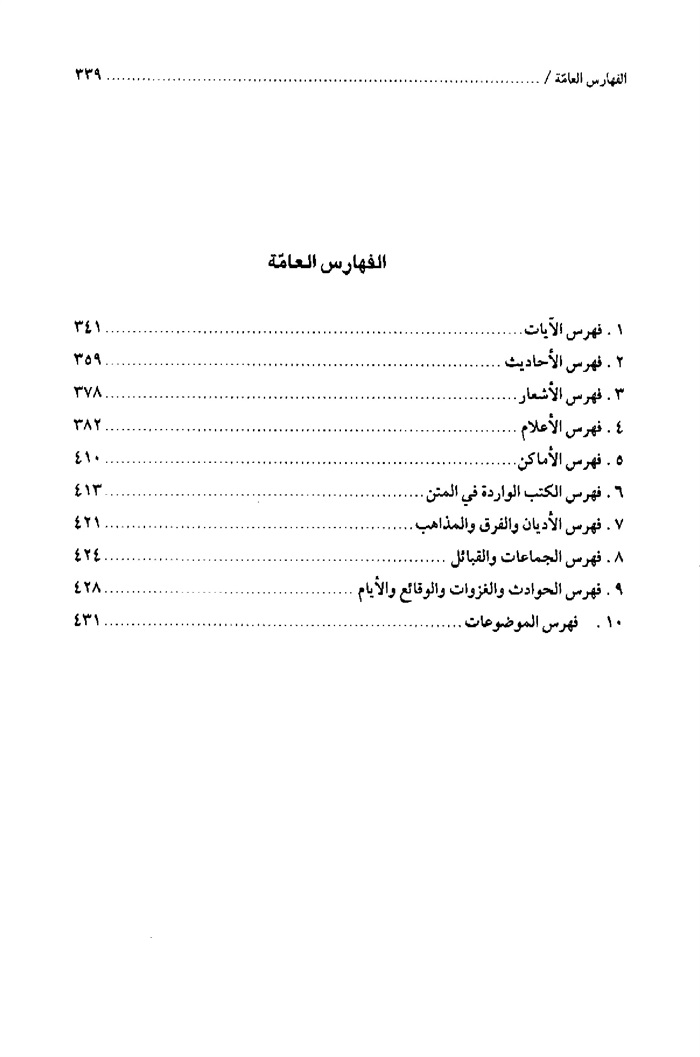
ص: 339
ص: 340
الصورة
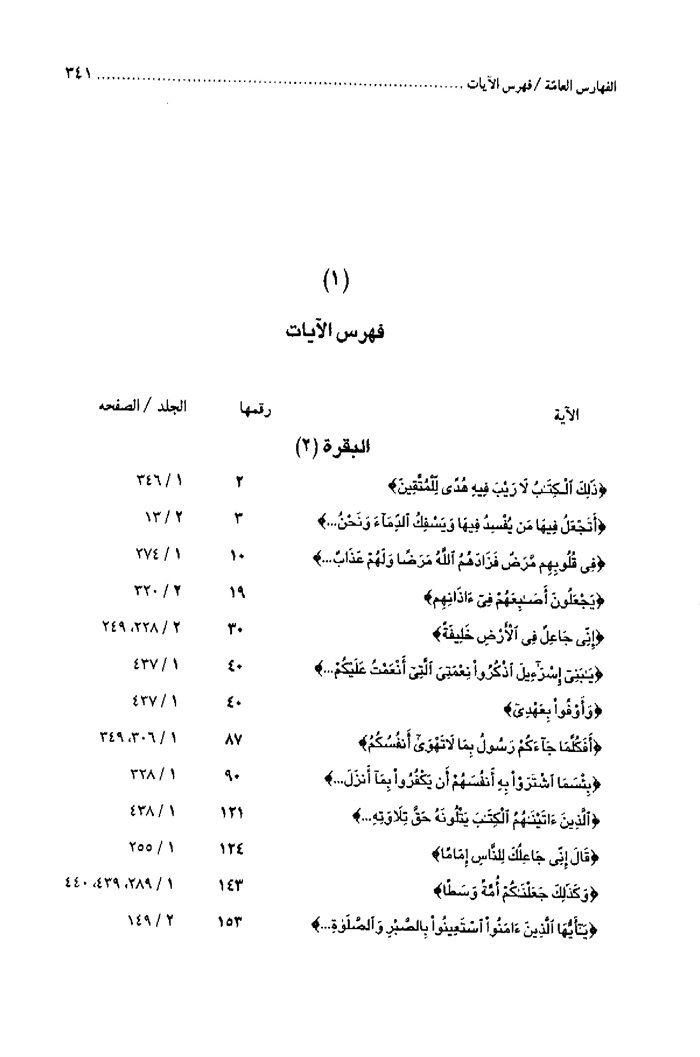
ص: 341
الصورة
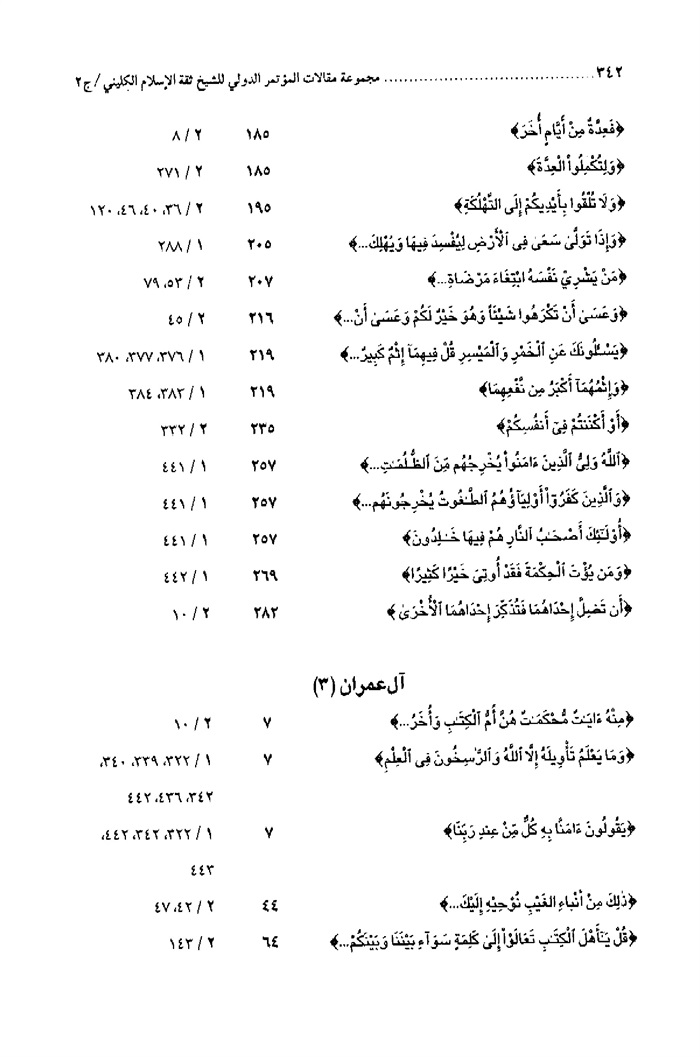
ص: 342
الصورة
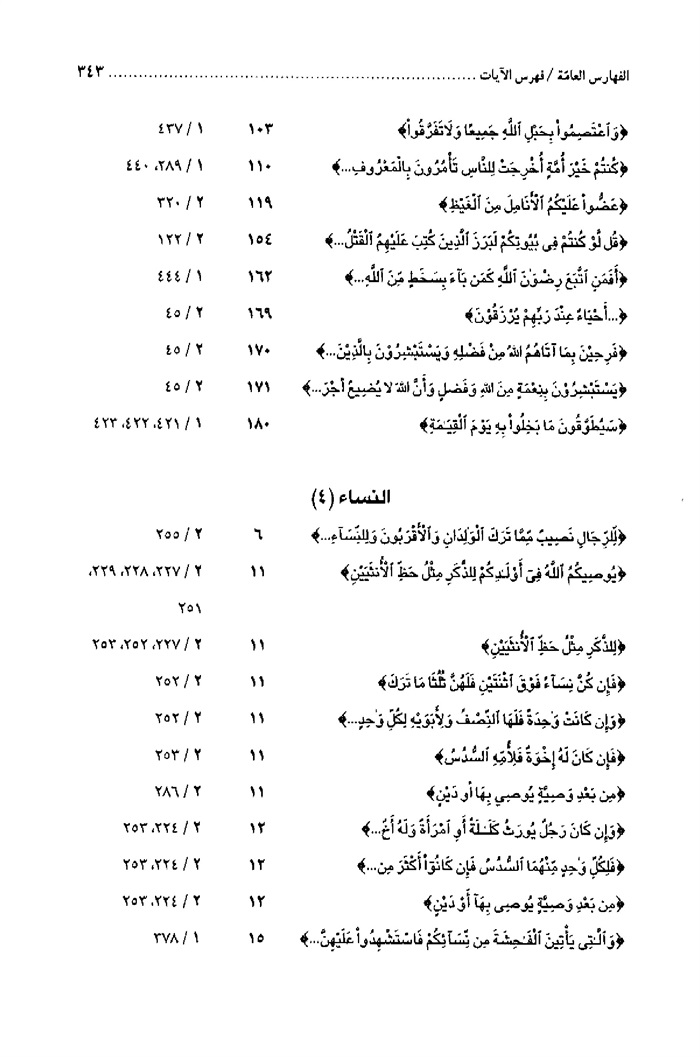
ص: 343
الصورة
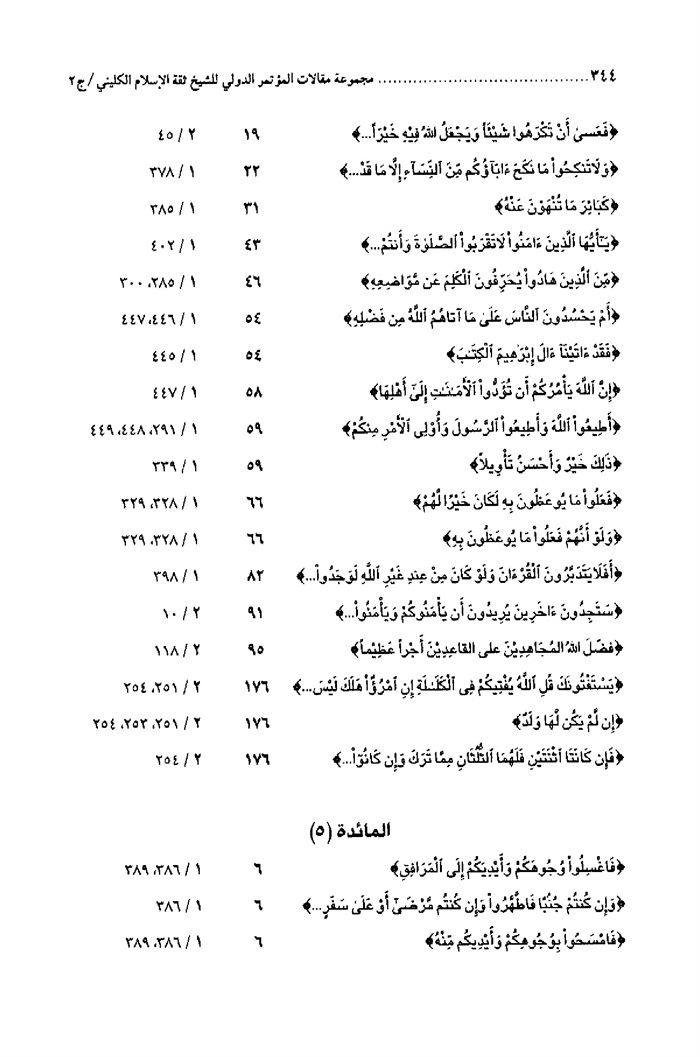
ص: 344
الصورة
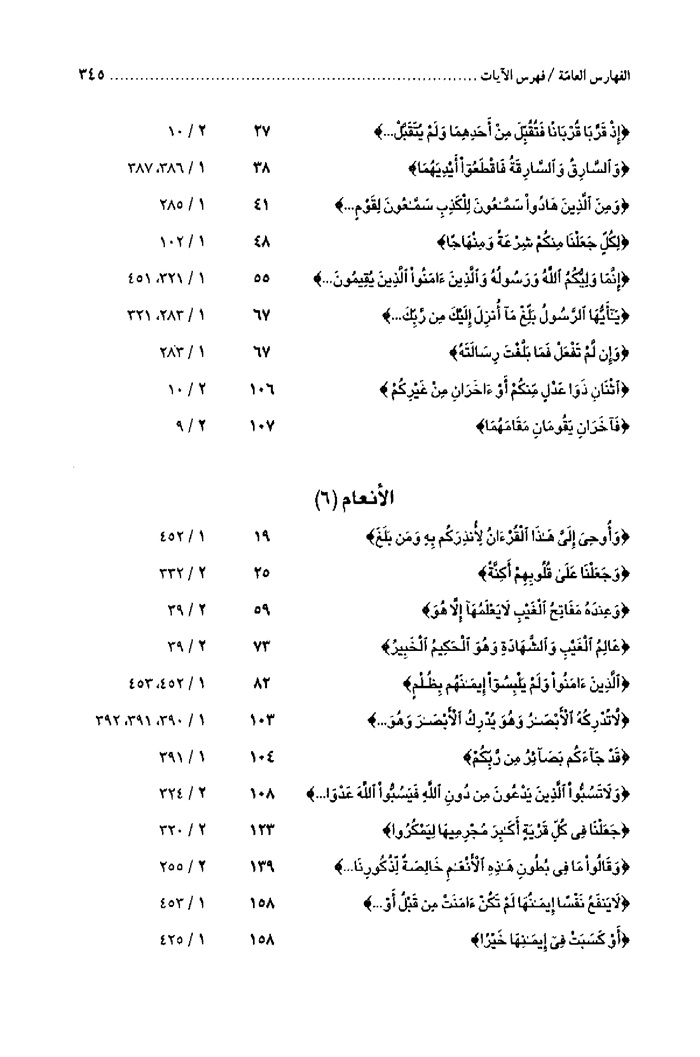
ص: 345
الصورة
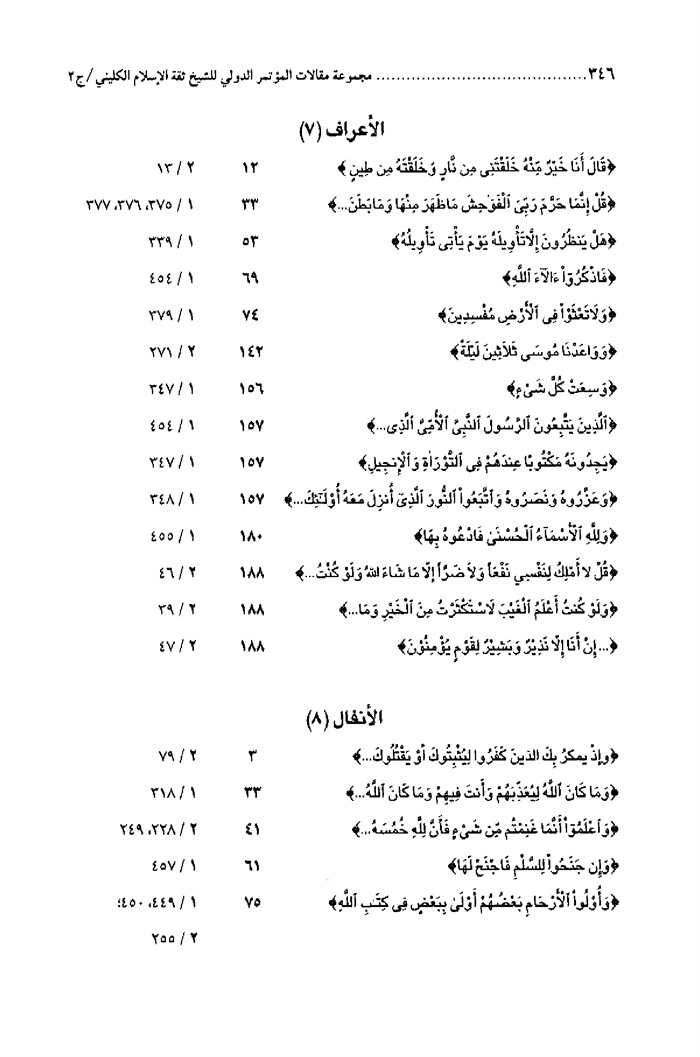
ص: 346
الصورة
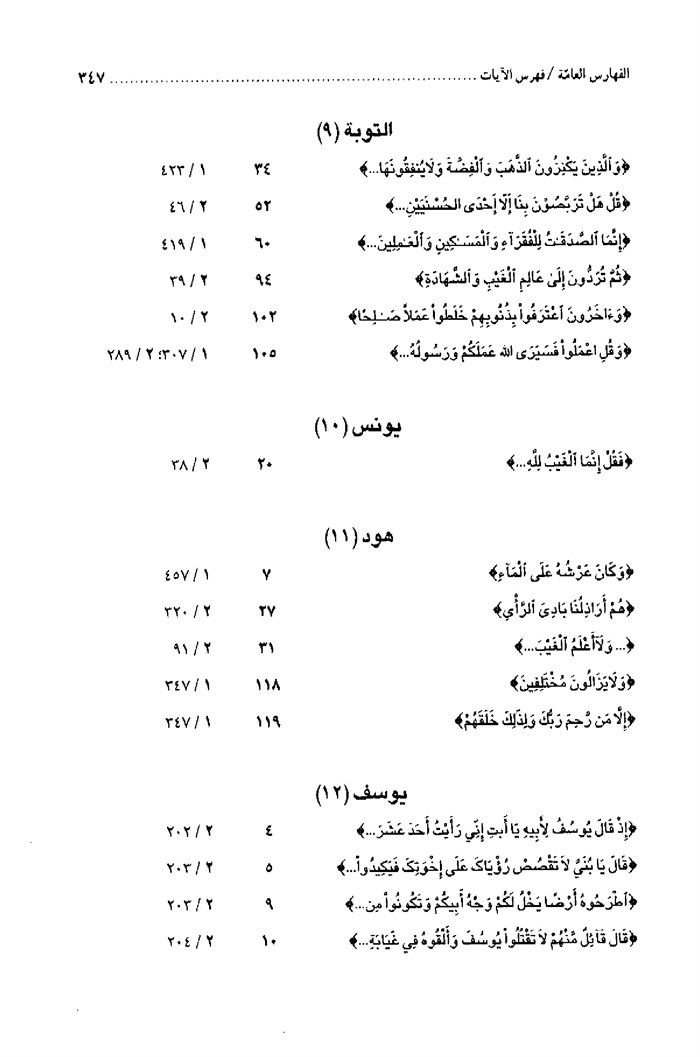
ص: 347
الصورة
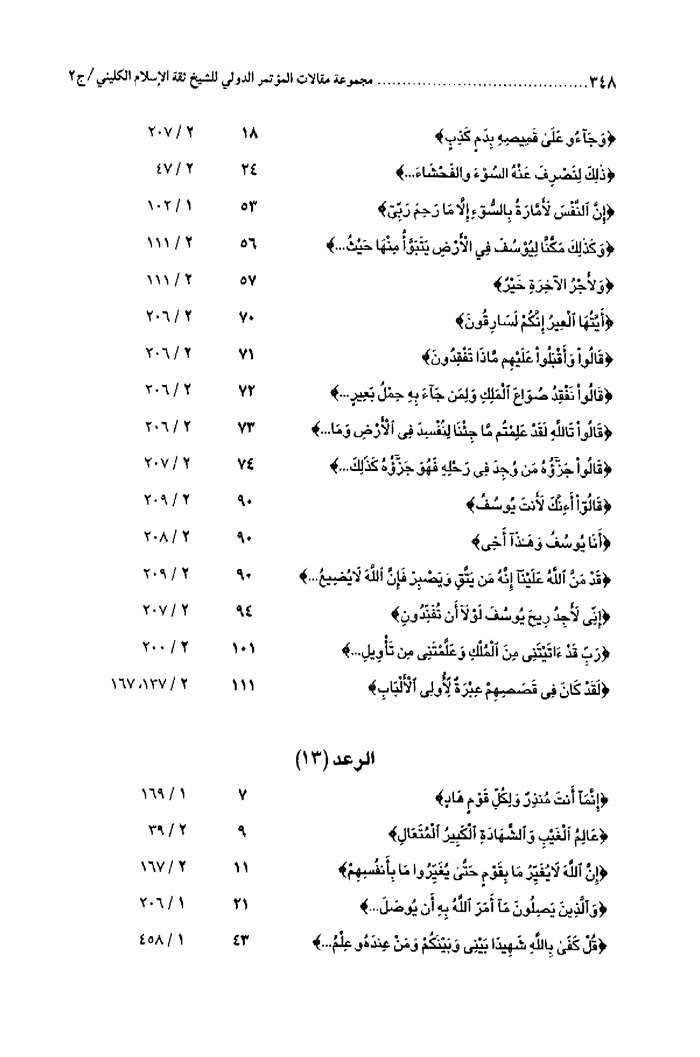
ص: 348
الصورة
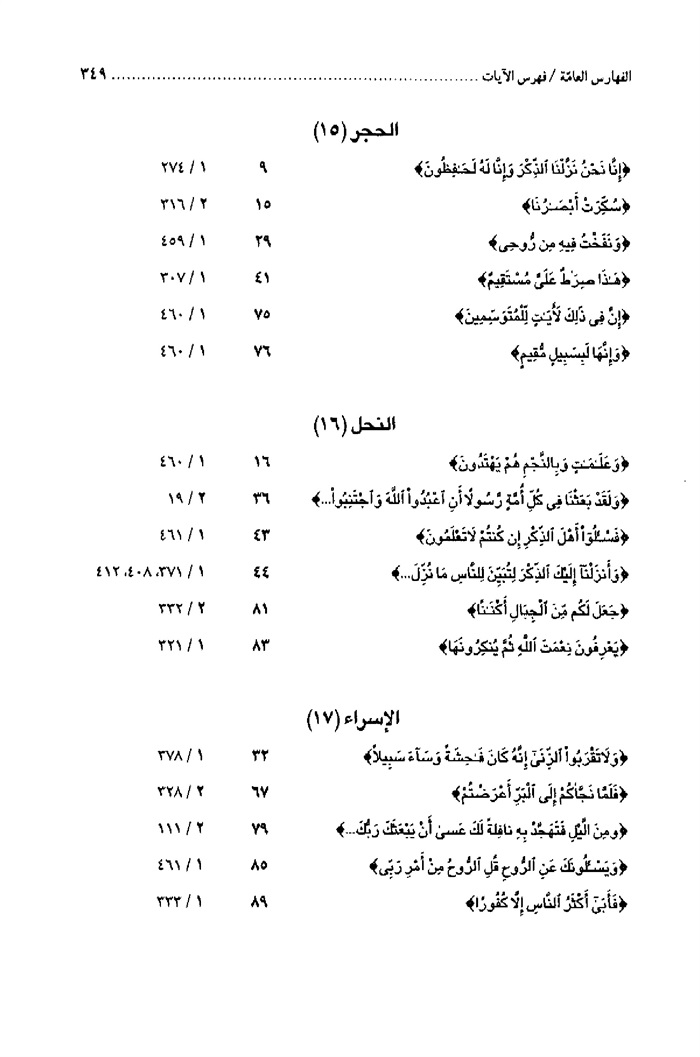
ص: 349
الصورة
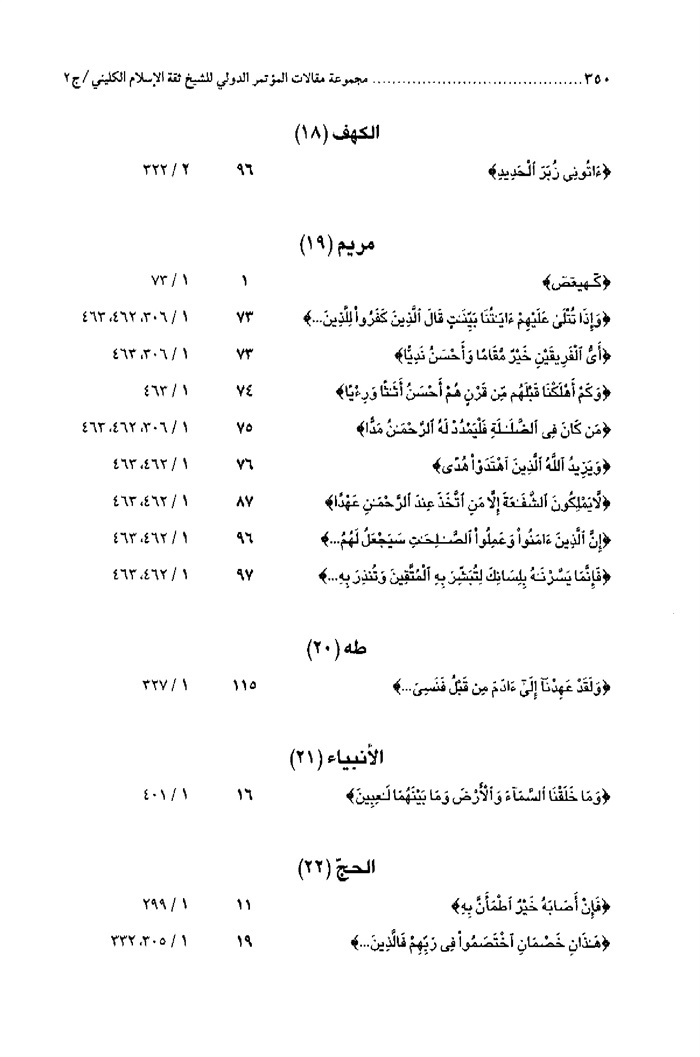
ص: 350
الصورة
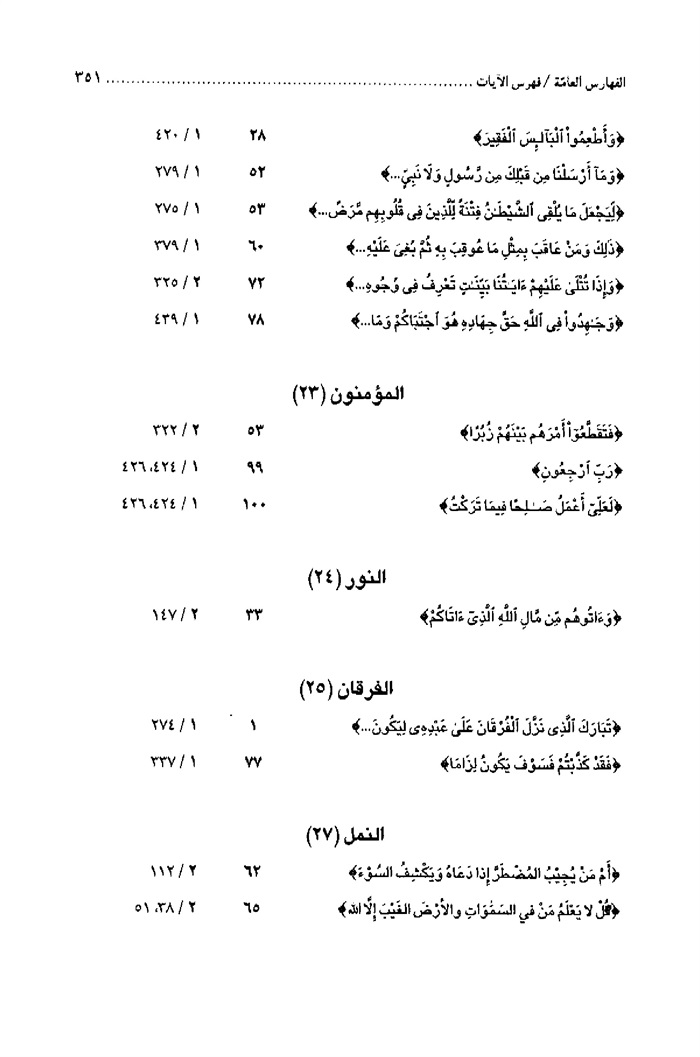
ص: 351
الصورة
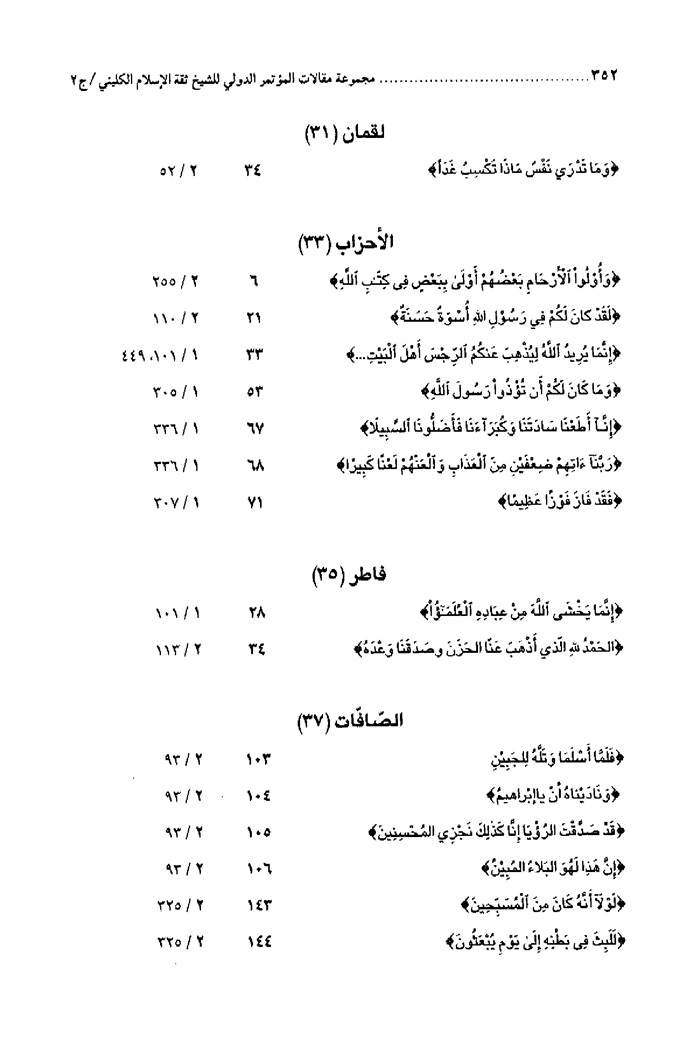
ص: 352
الصورة
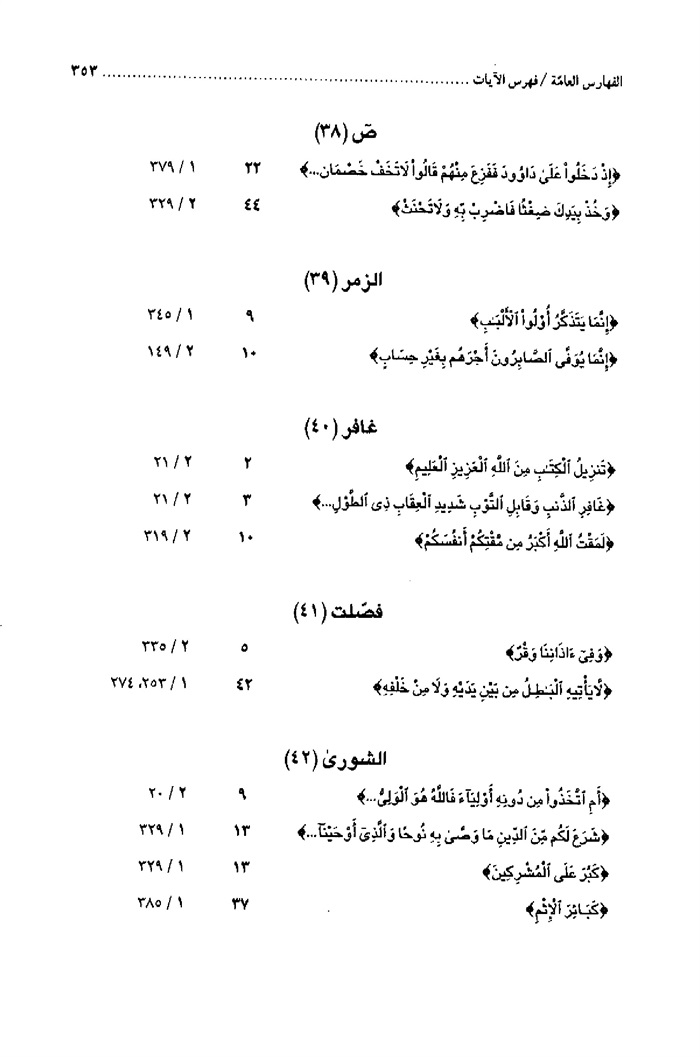
ص: 353
الصورة
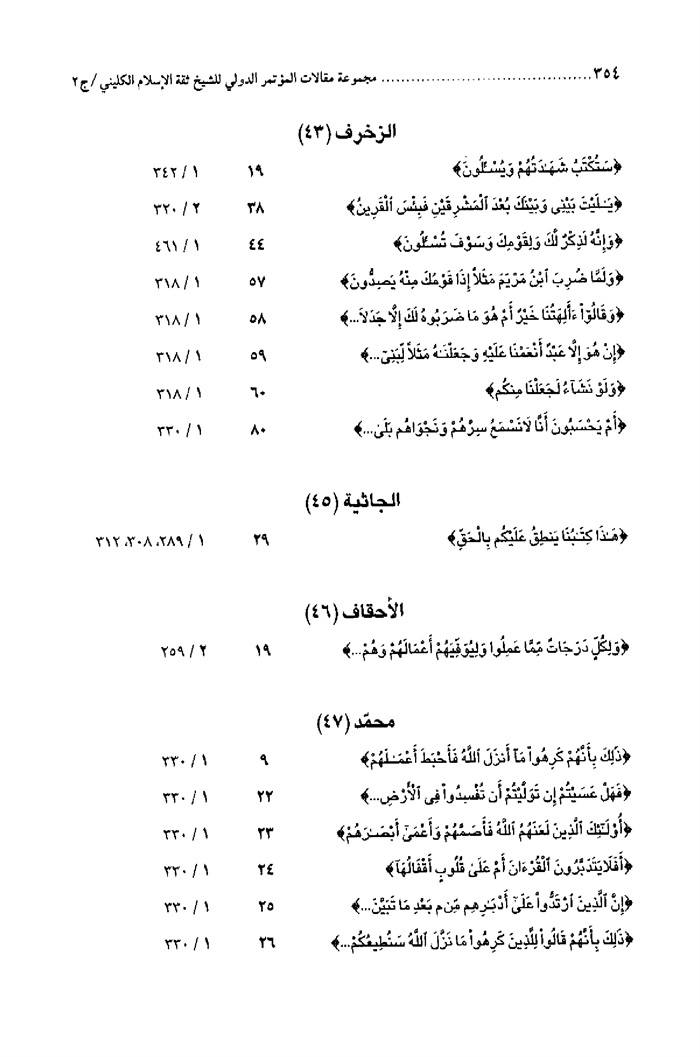
ص: 354
الصورة
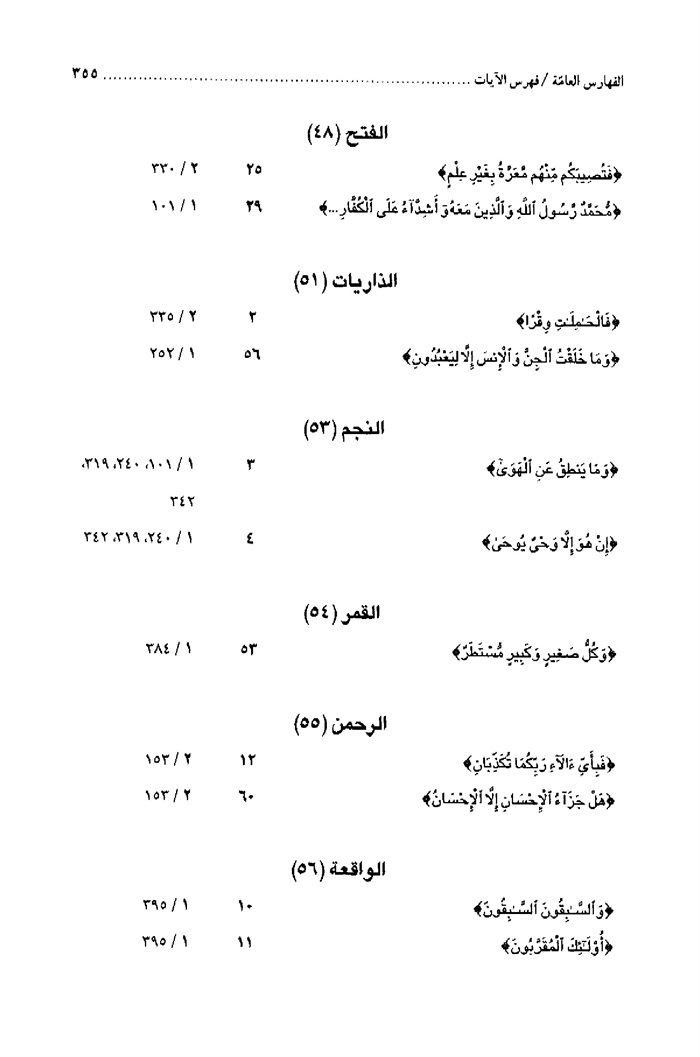
ص: 355
الصورة
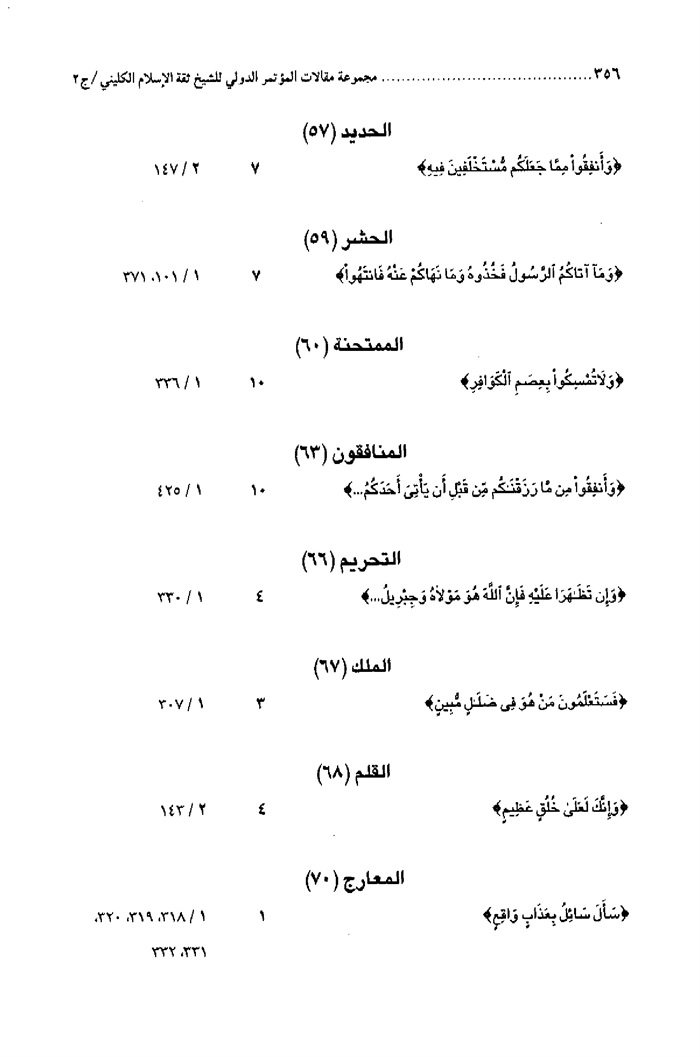
ص: 356
الصورة
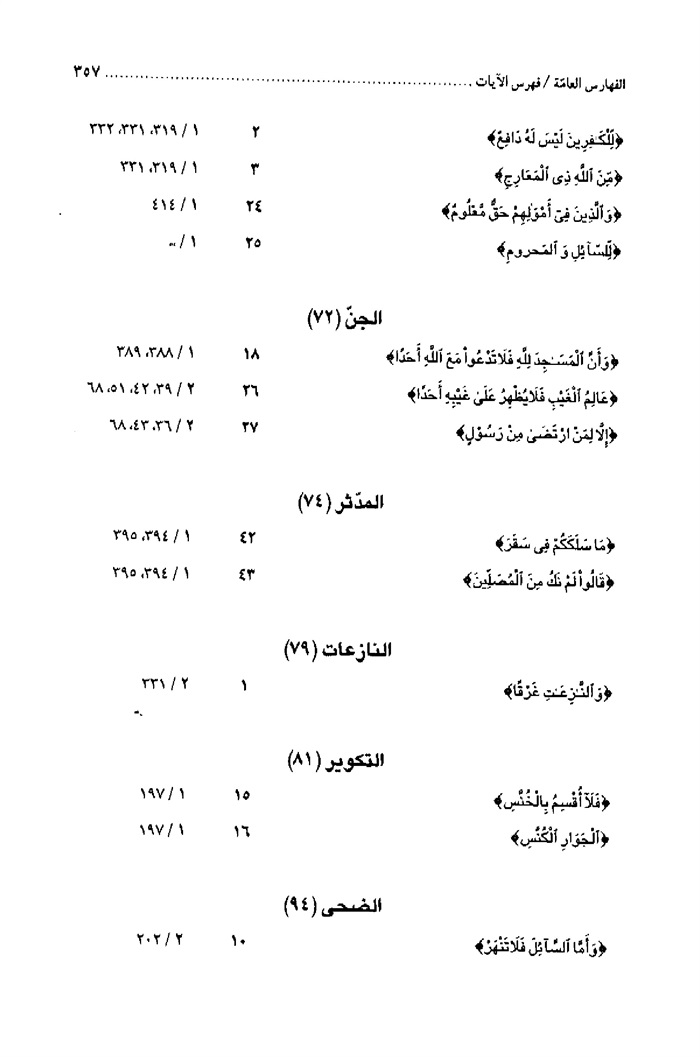
ص: 357
الصورة
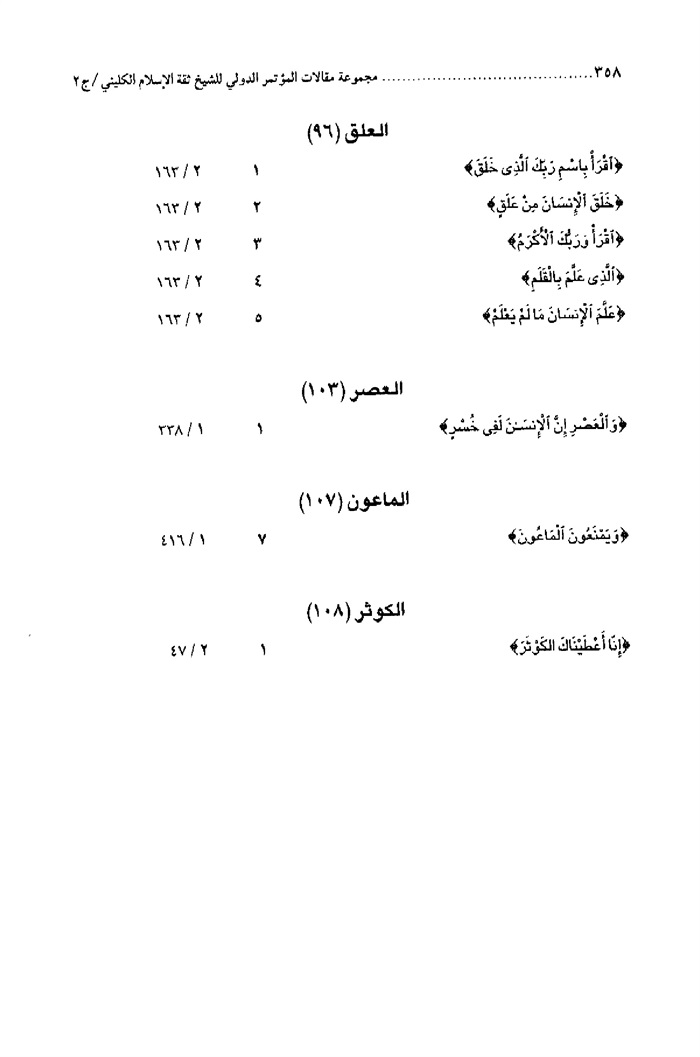
ص: 358
الصورة
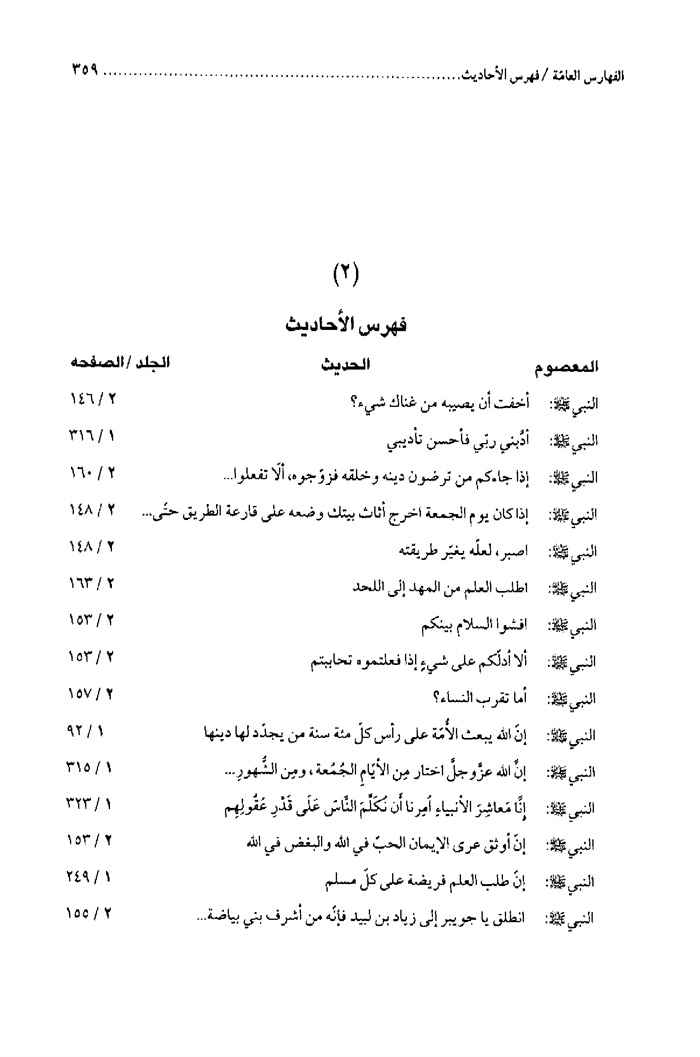
ص: 359
الصورة
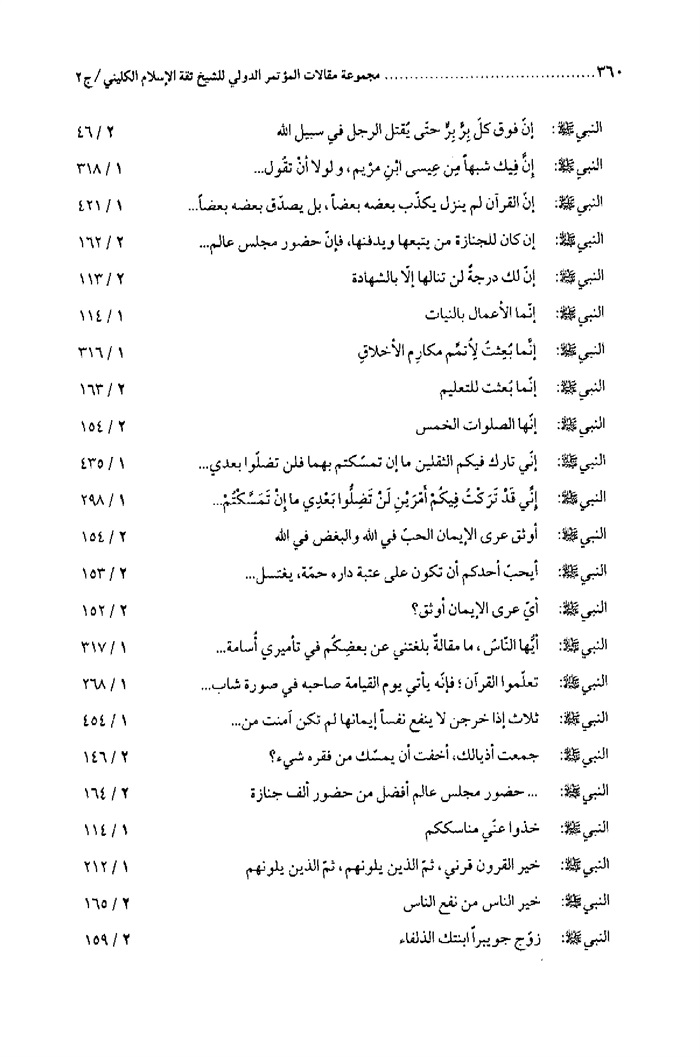
ص: 360
الصورة
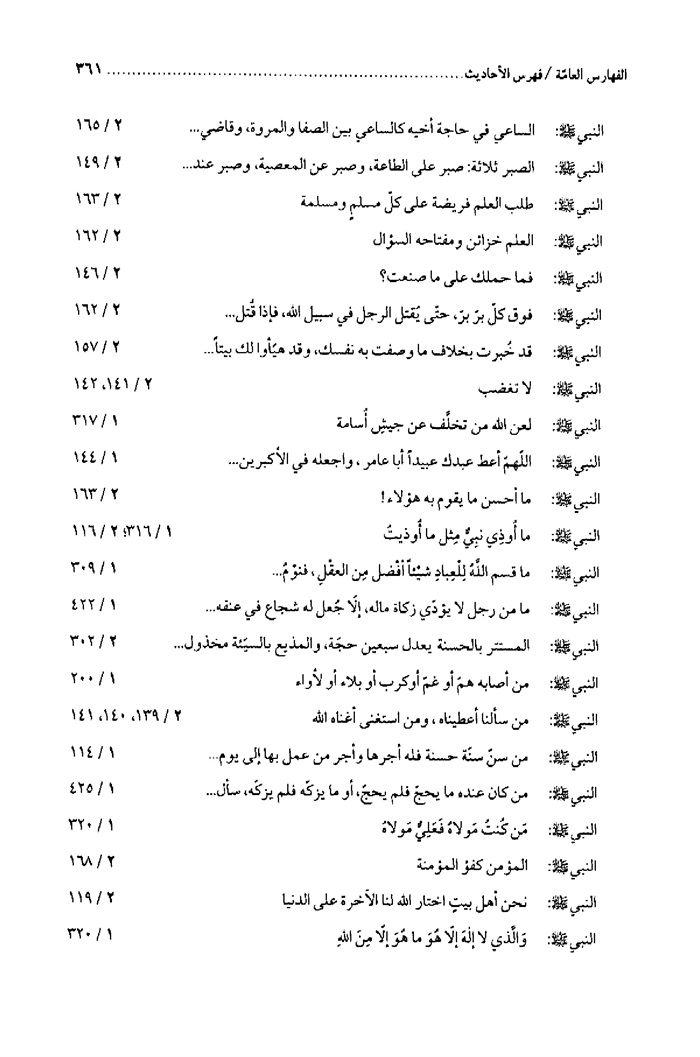
ص: 361
الصورة
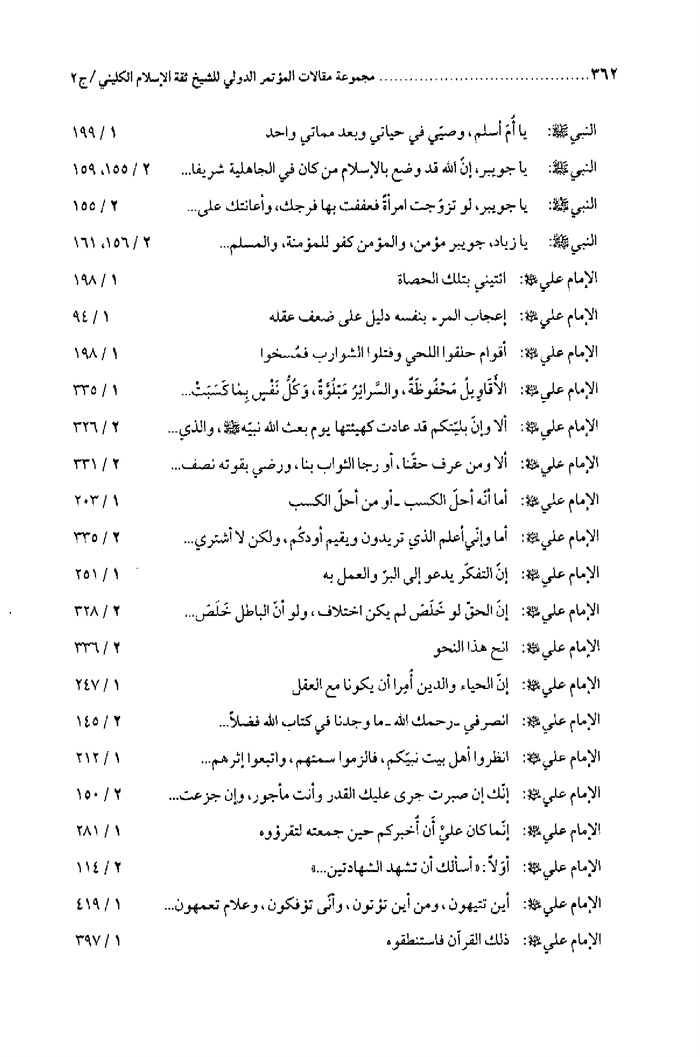
ص: 362
الصورة
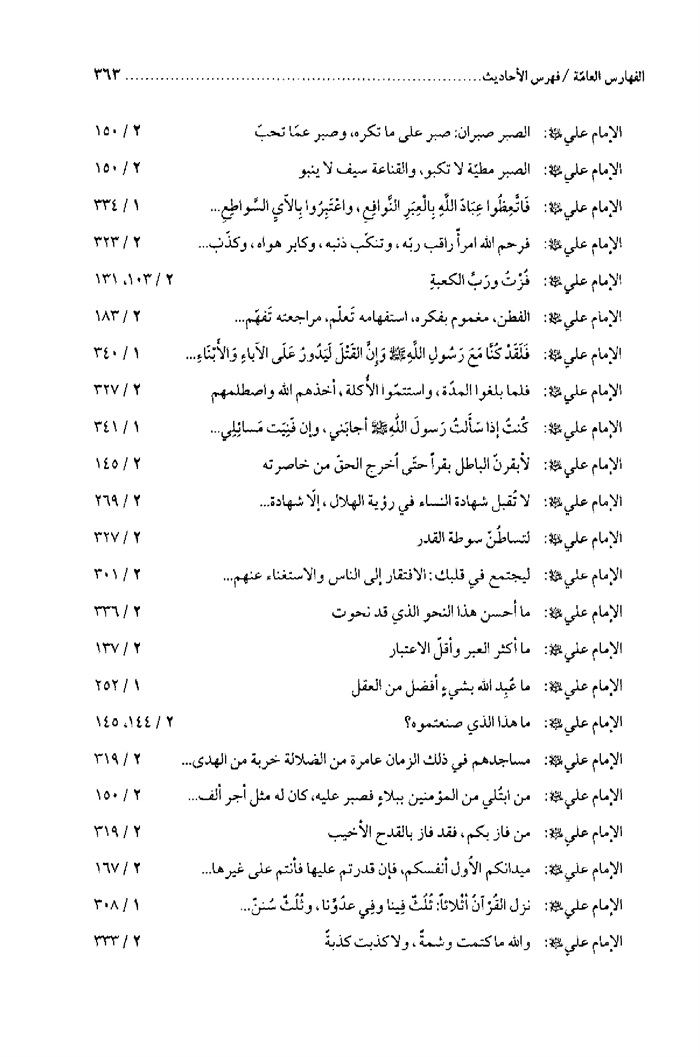
ص: 363
الصورة
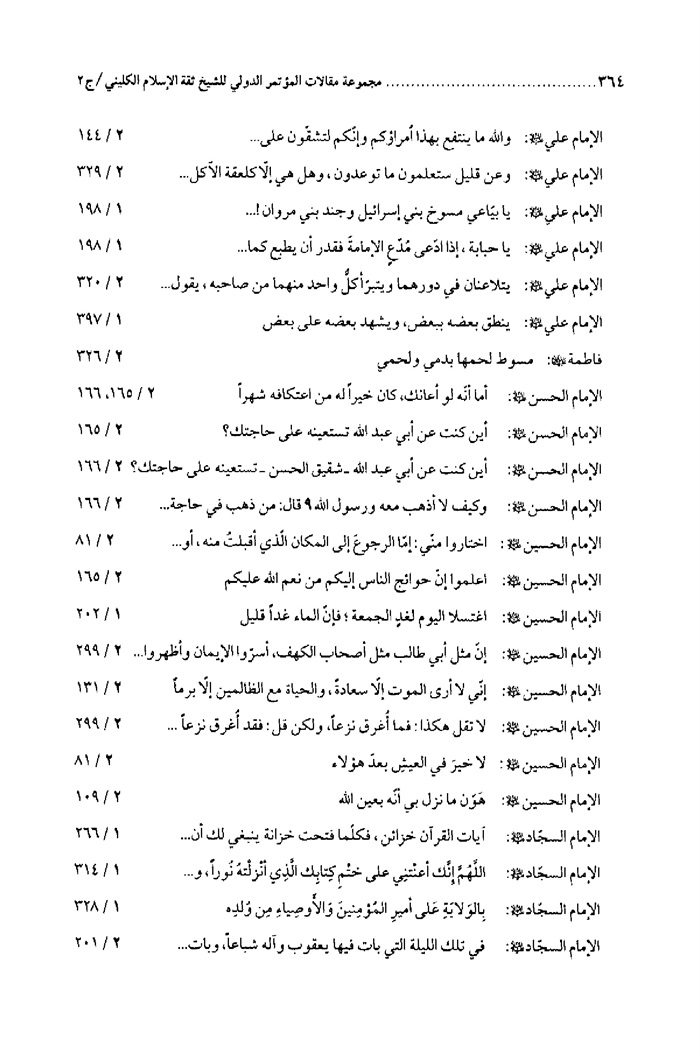
ص: 364
الصورة
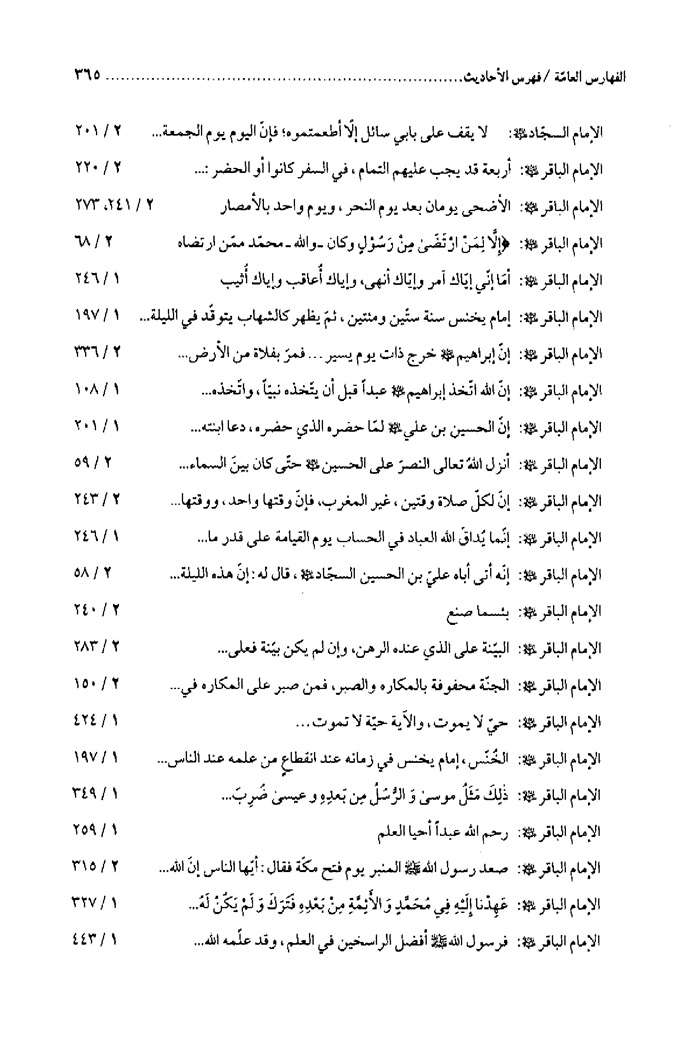
ص: 365
الصورة
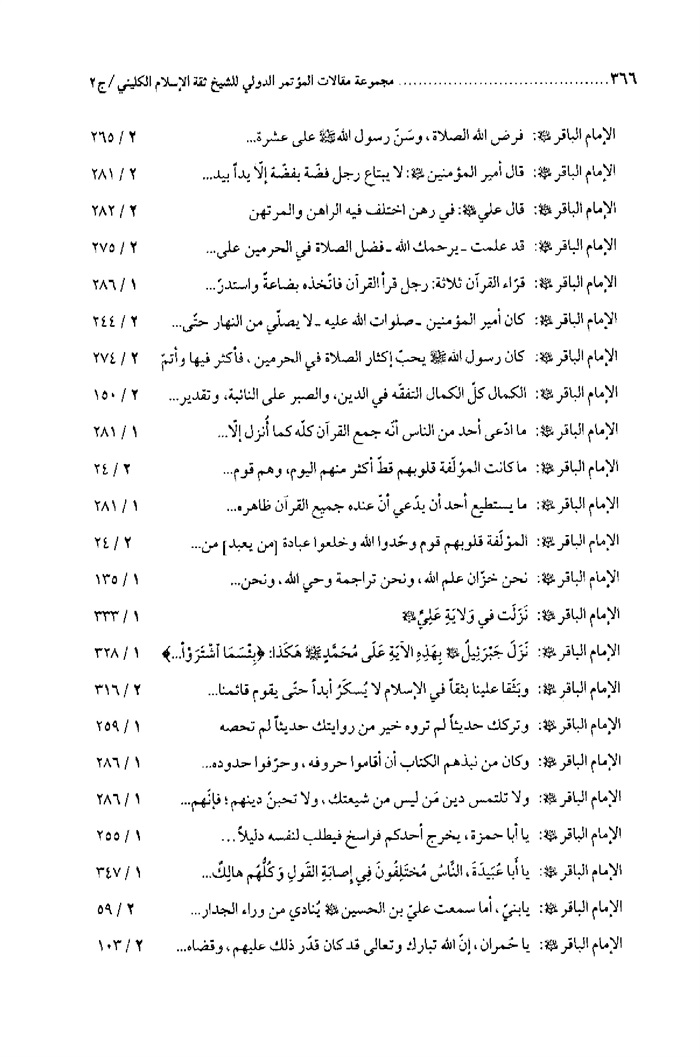
ص: 366
الصورة
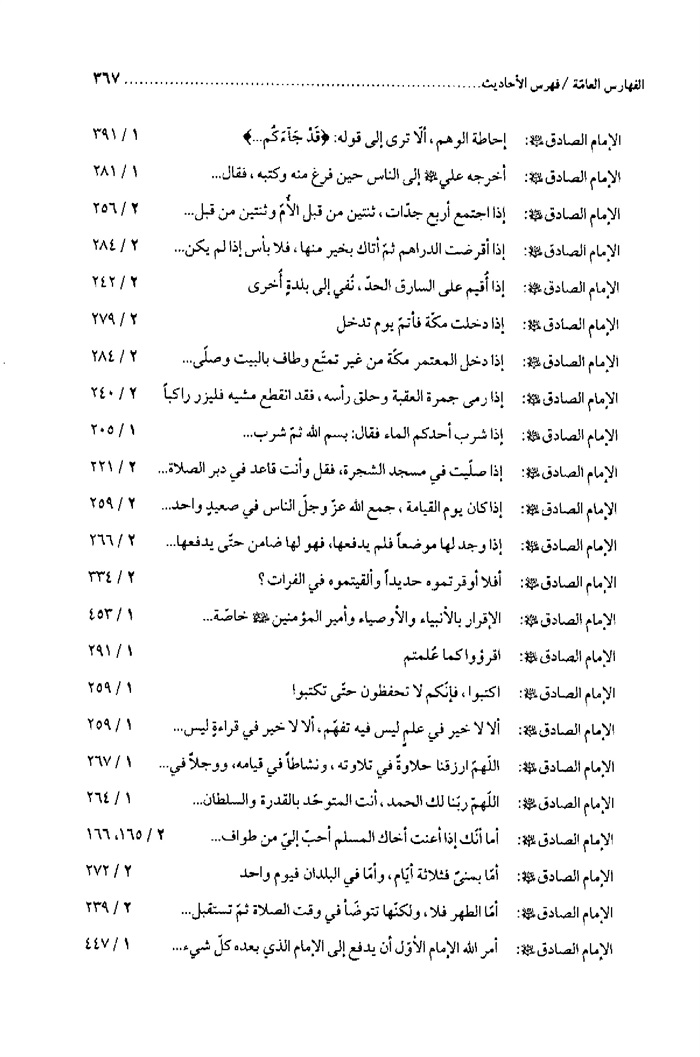
ص: 367
الصورة
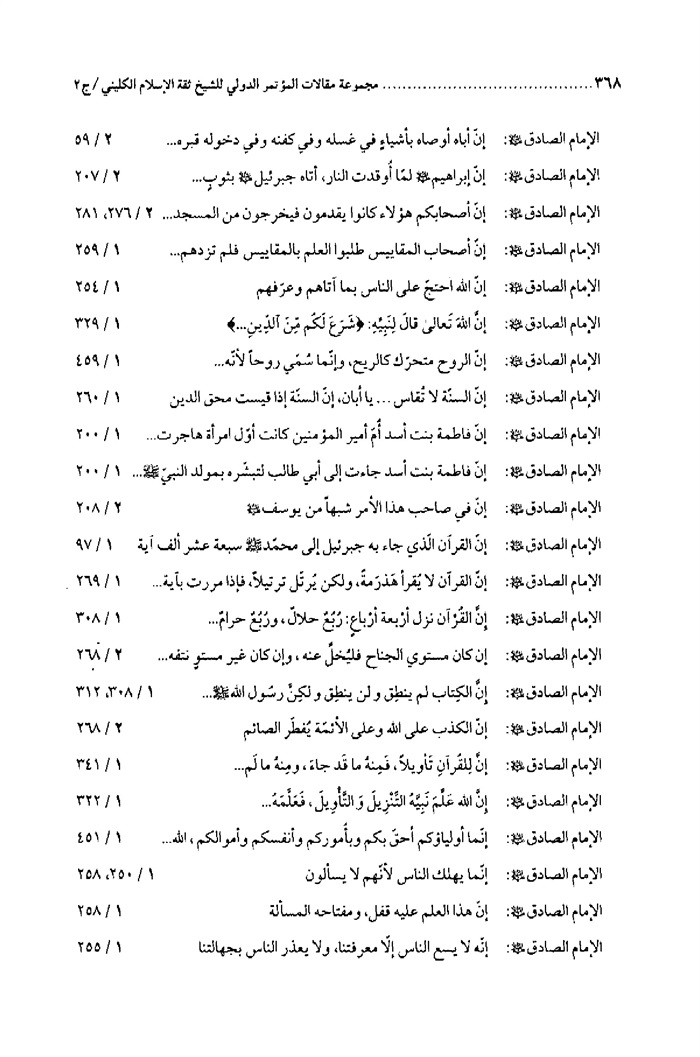
ص: 368
الصورة
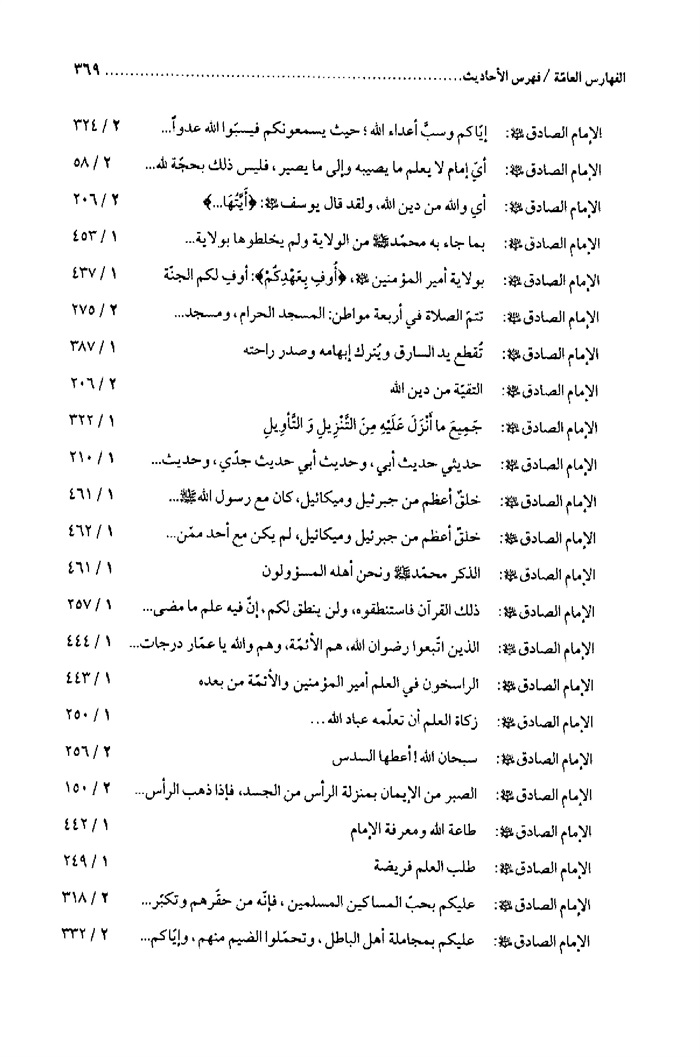
ص: 369
الصورة
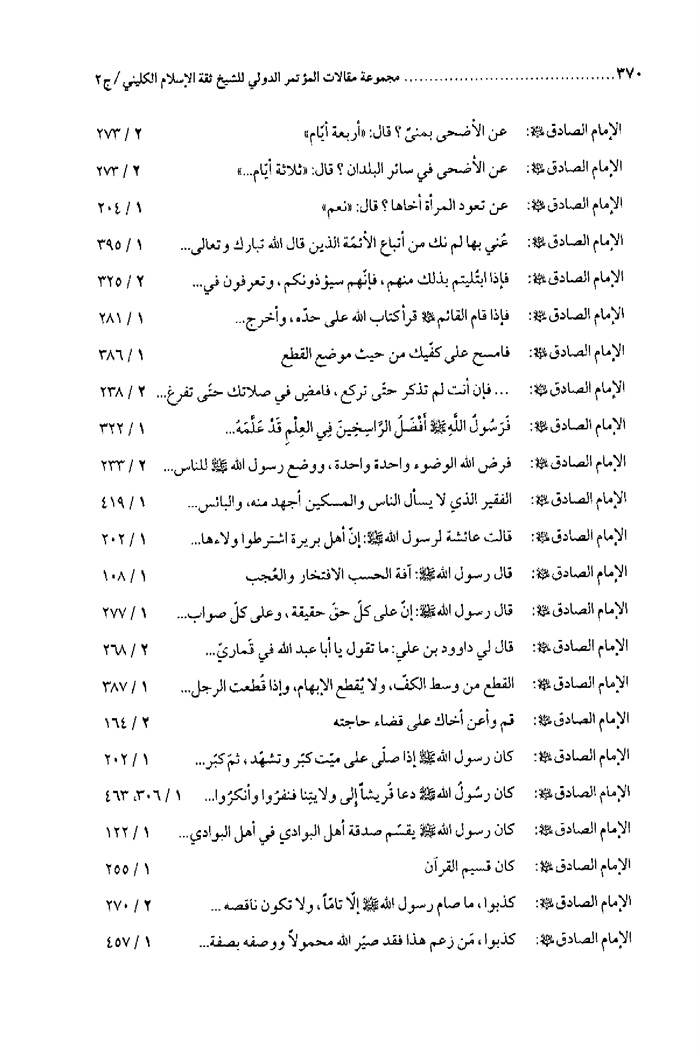
ص: 370
الصورة
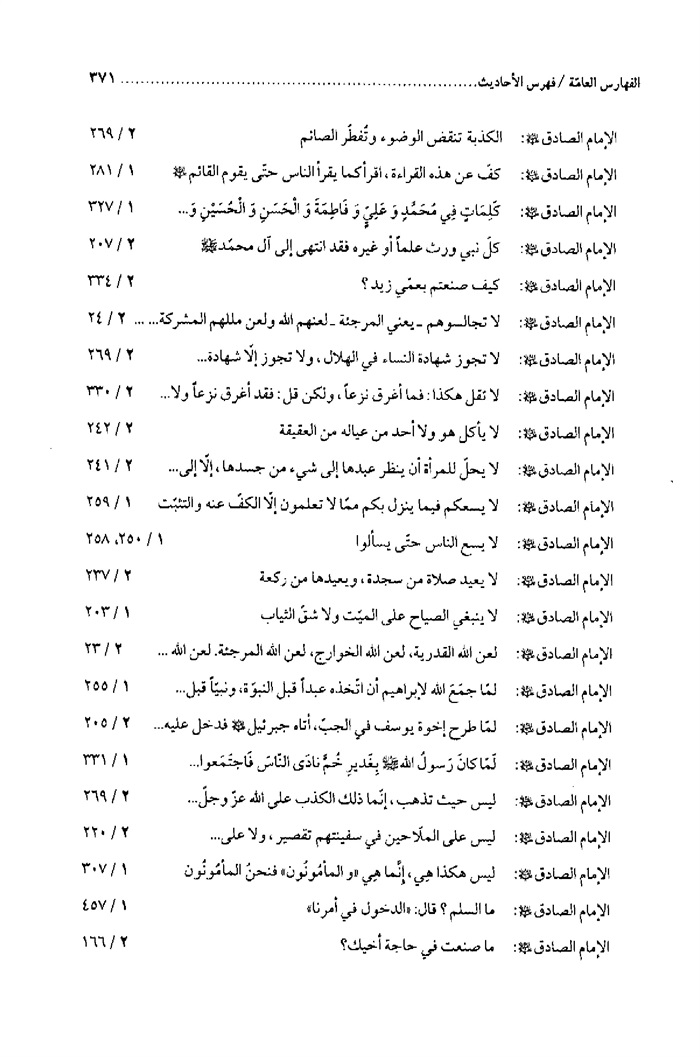
ص: 371
الصورة
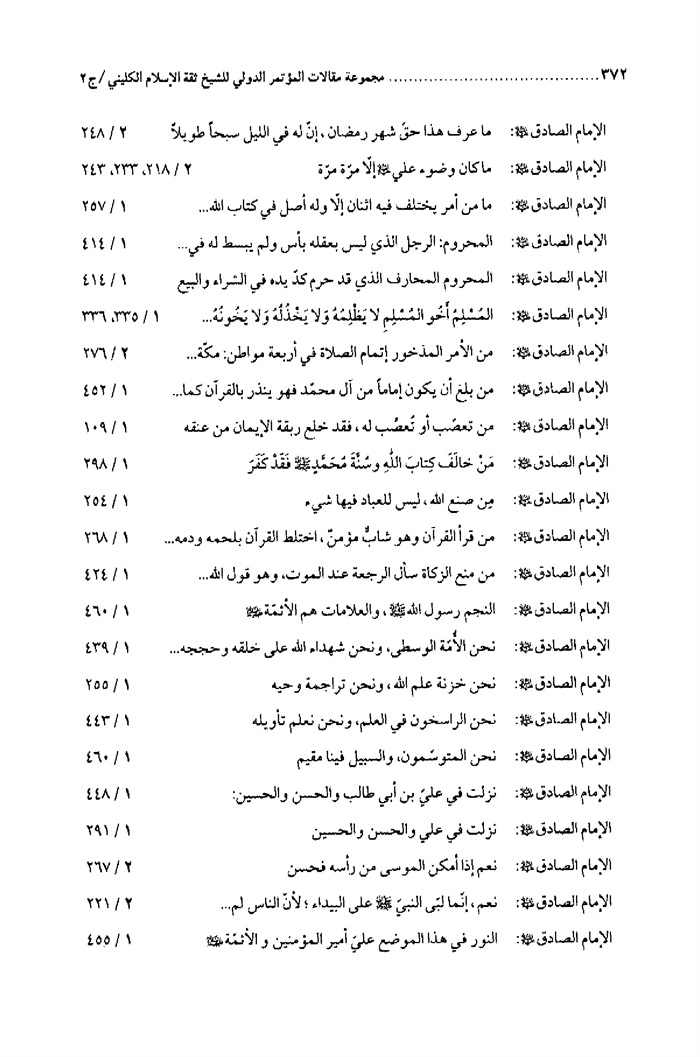
ص: 372
الصورة
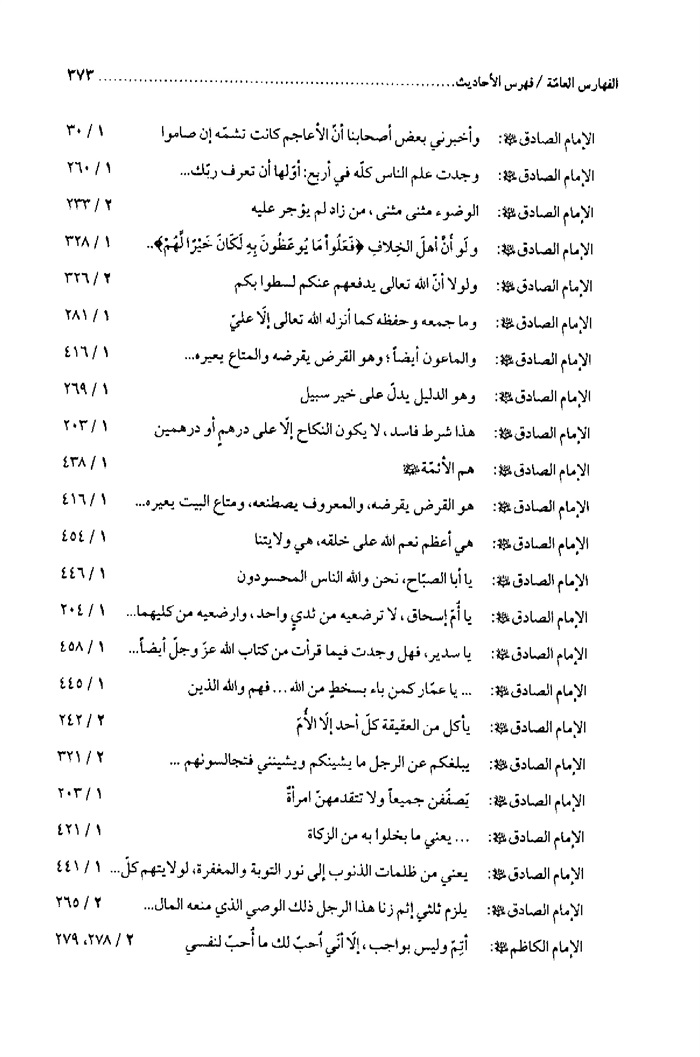
ص: 373
الصورة
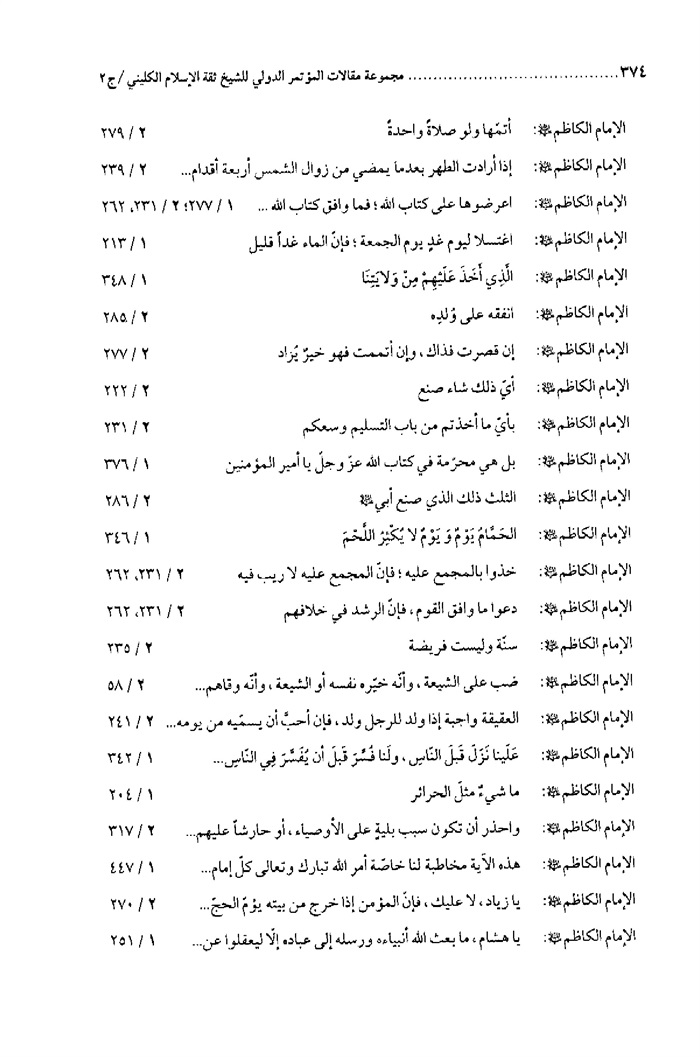
ص: 374
الصورة
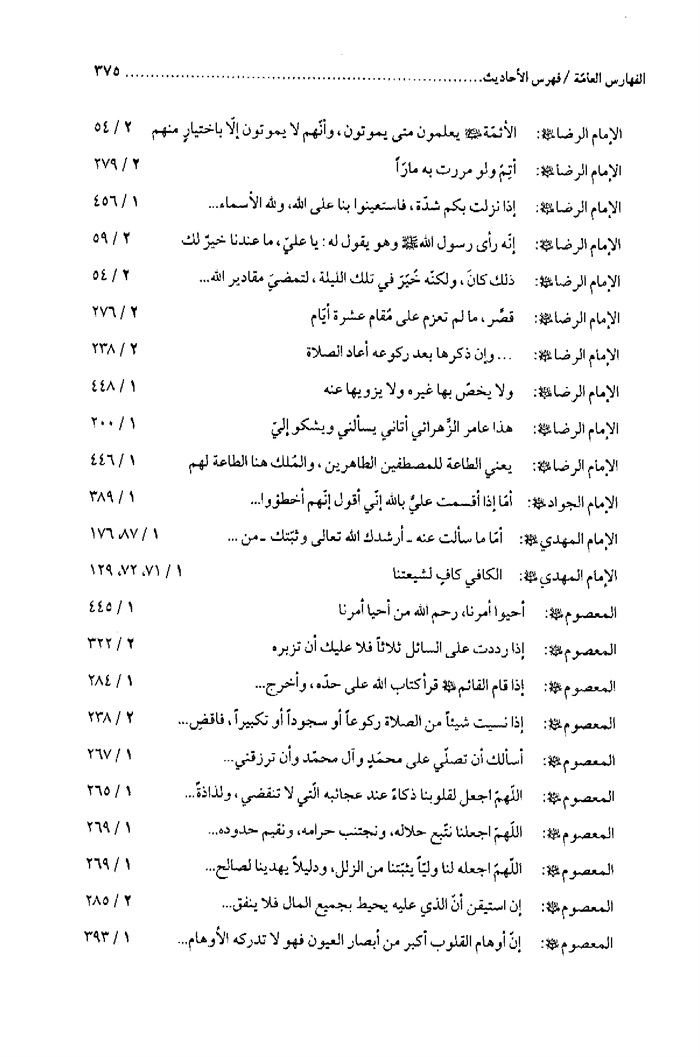
ص: 375
الصورة
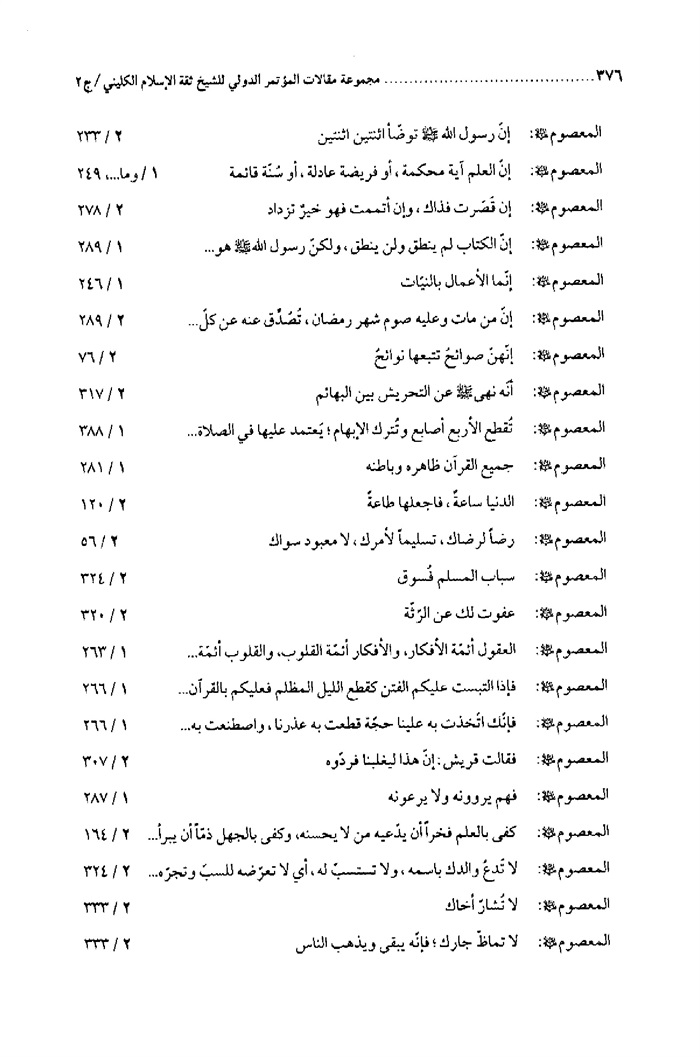
ص: 376
الصورة
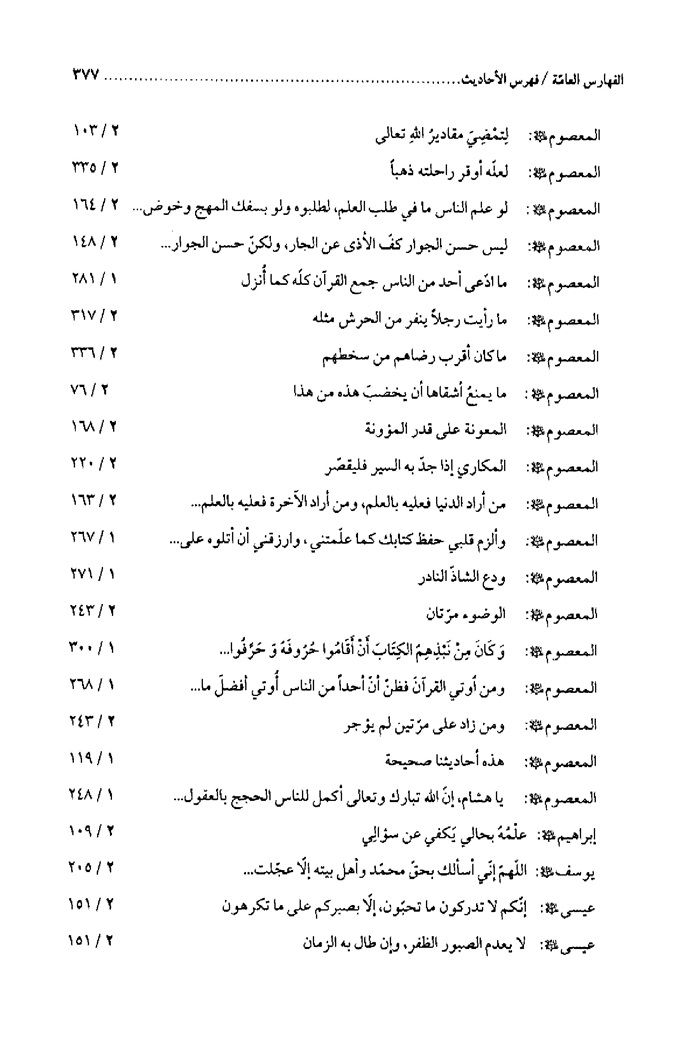
ص: 377
الصورة
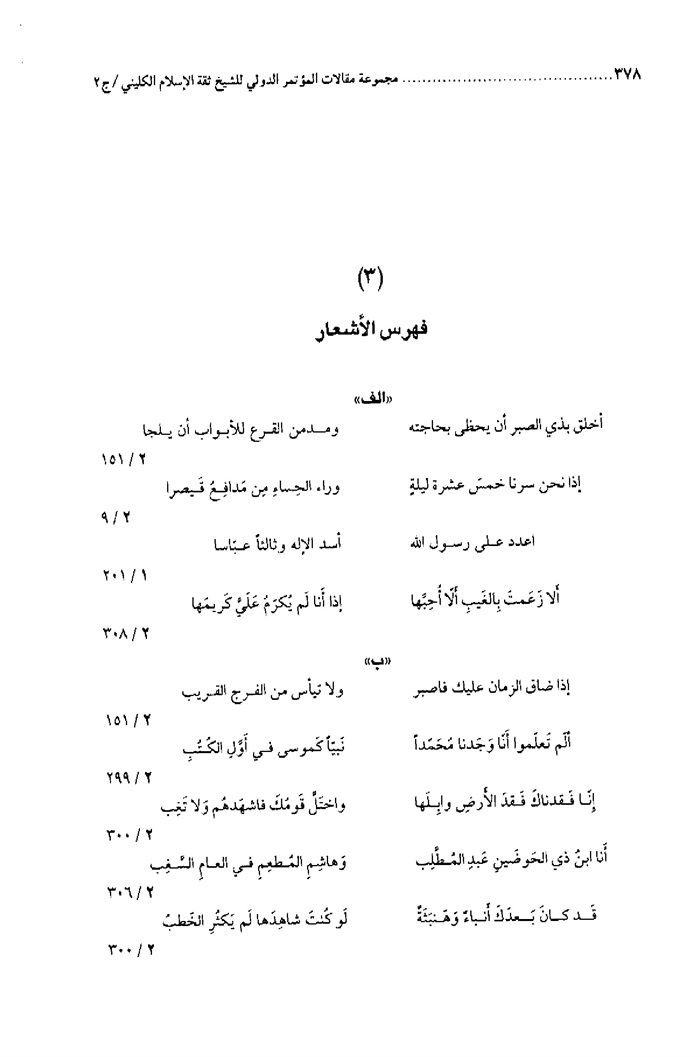
ص: 378
الصورة
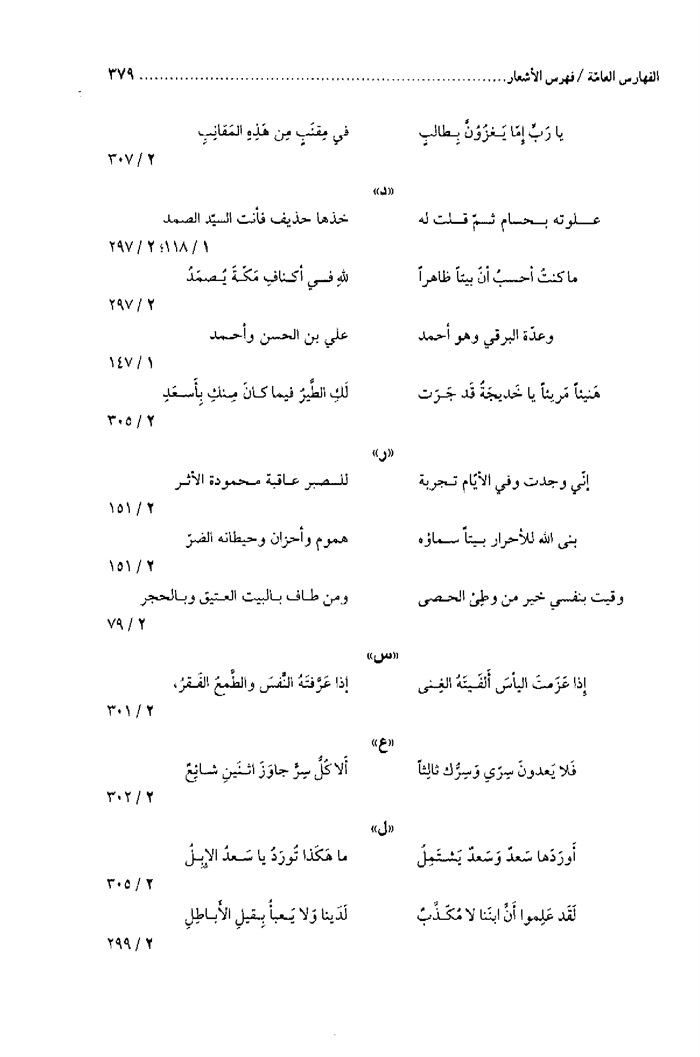
ص: 379
الصورة
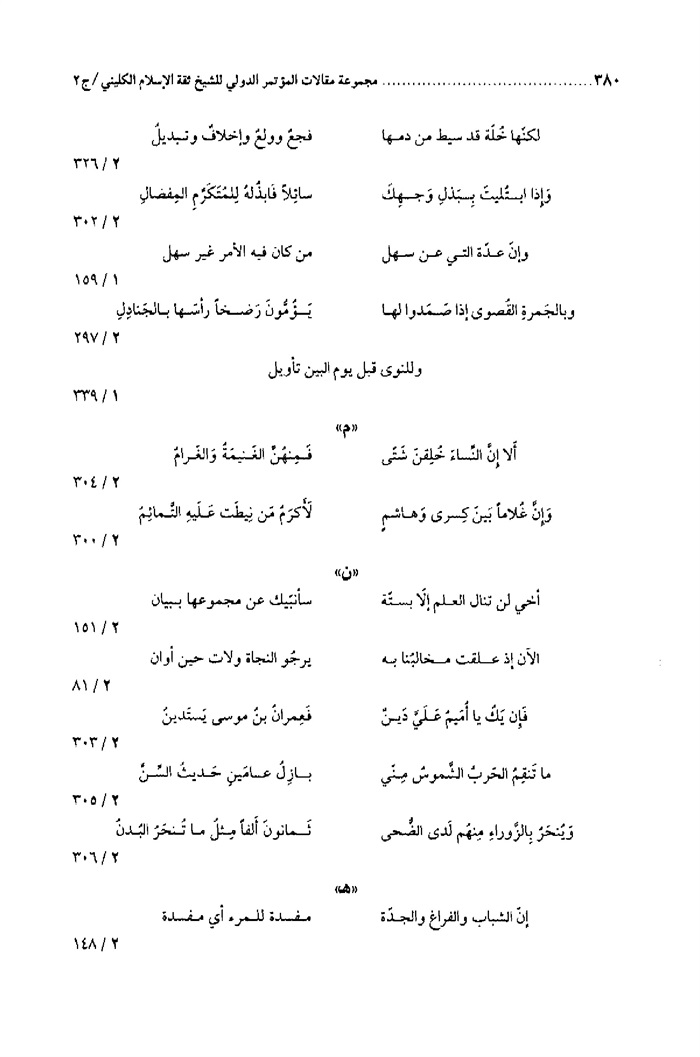
ص: 380
الصورة
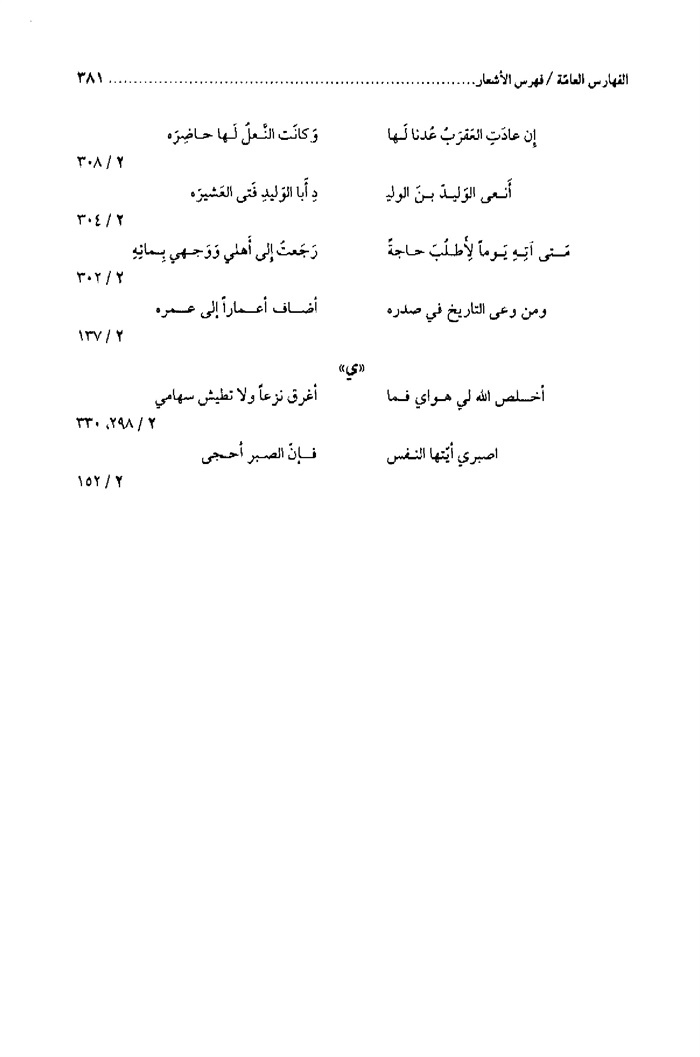
ص: 381
الصورة
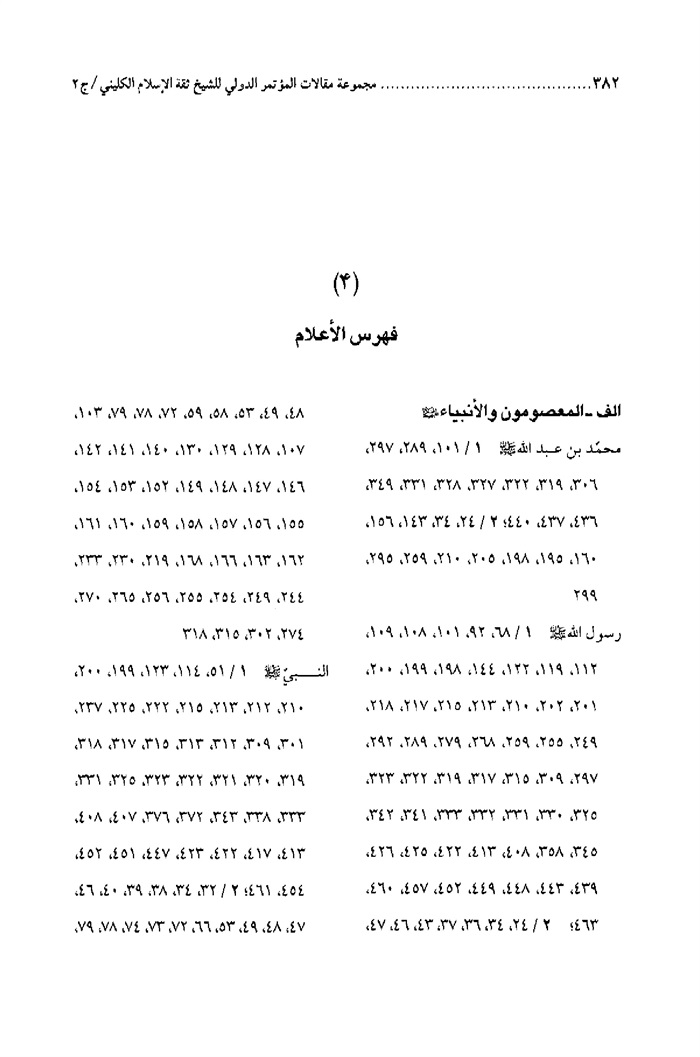
ص: 382
الصورة
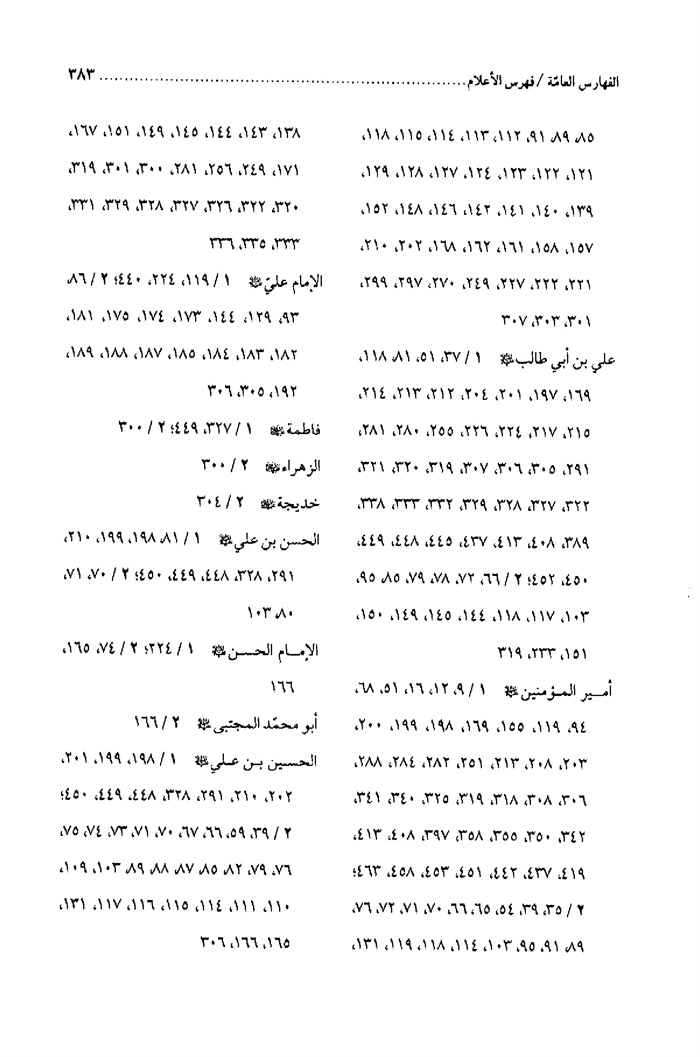
ص: 383
الصورة
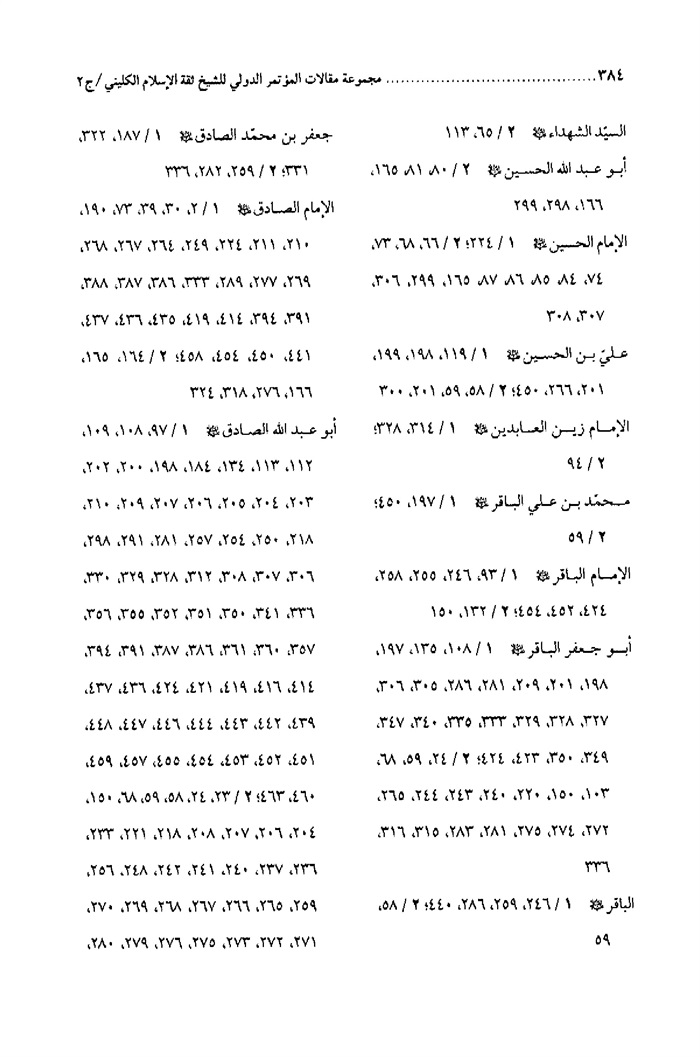
ص: 384
الصورة
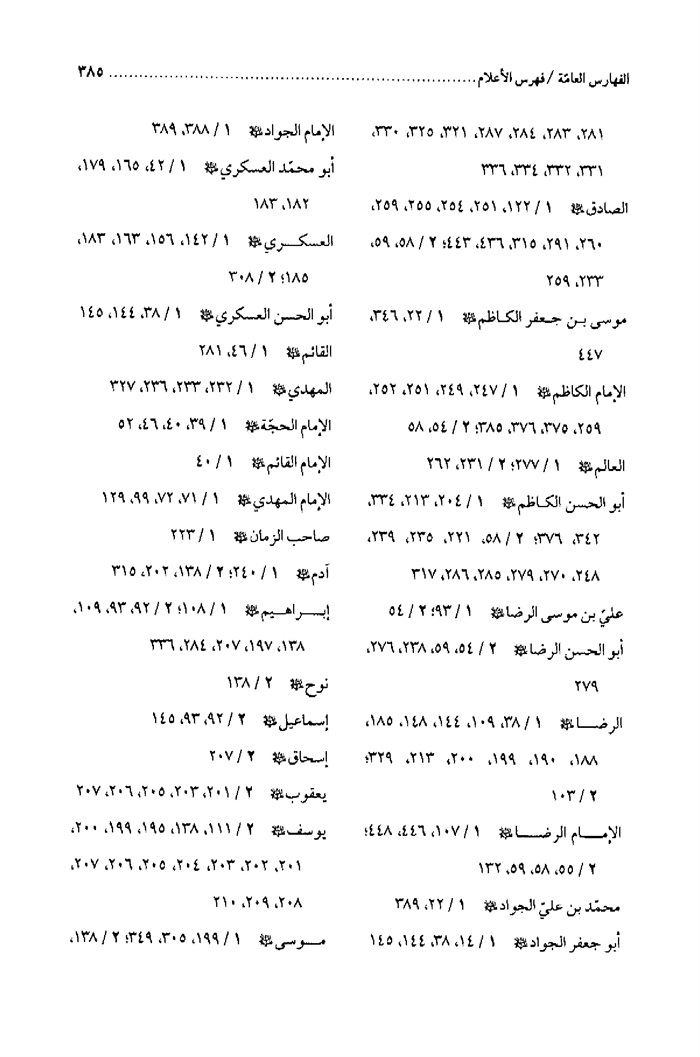
ص: 385
الصورة
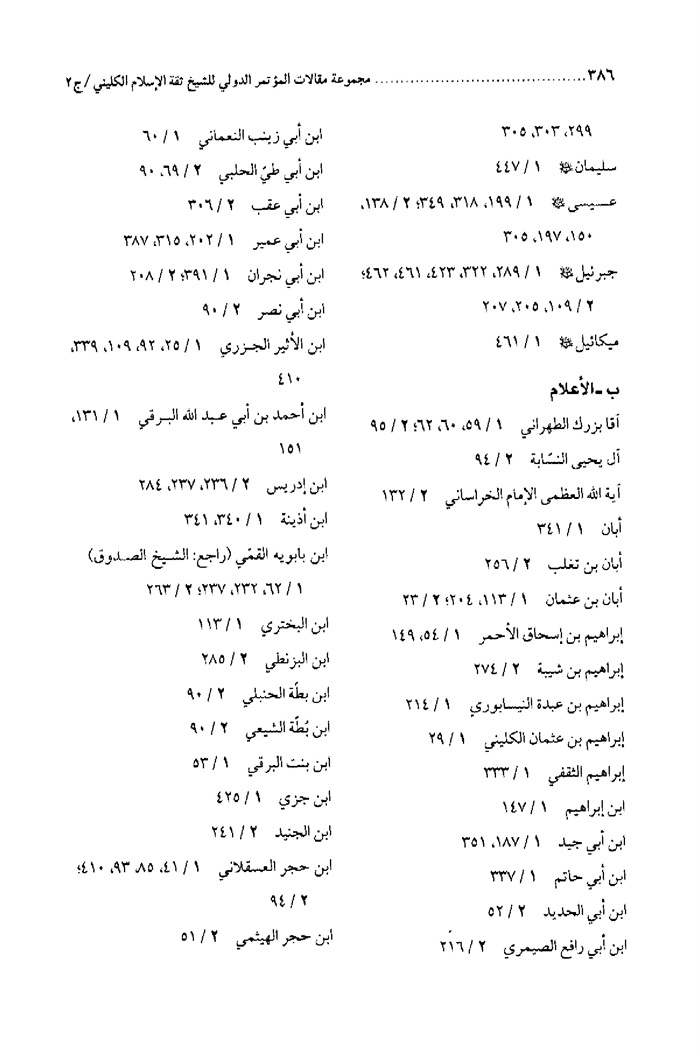
ص: 386
الصورة
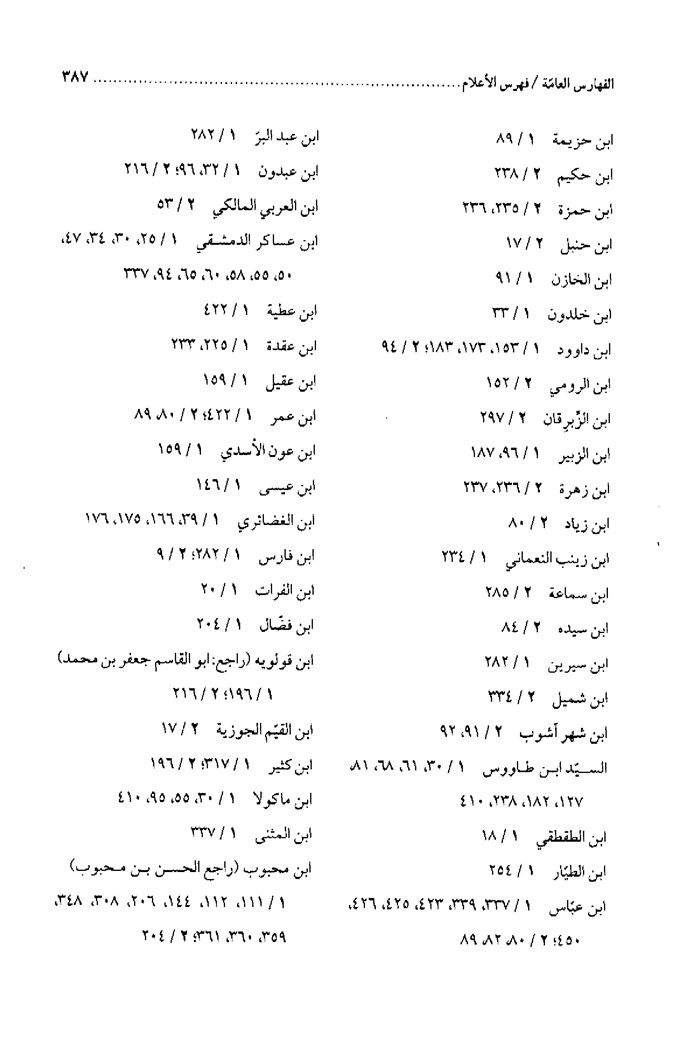
ص: 387
الصورة
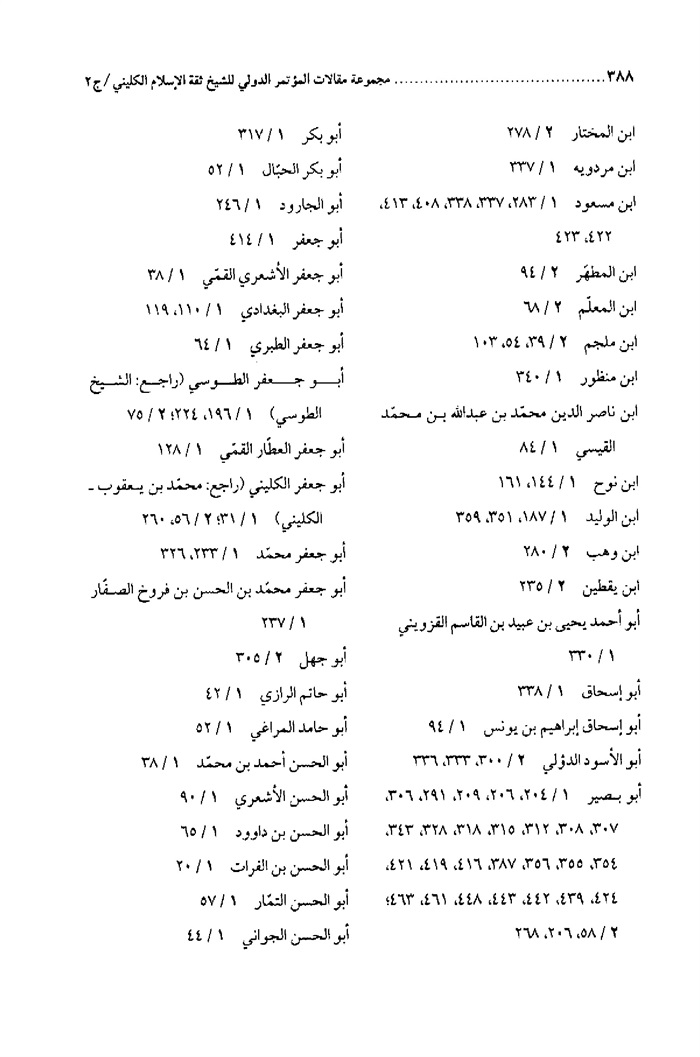
ص: 388
الصورة
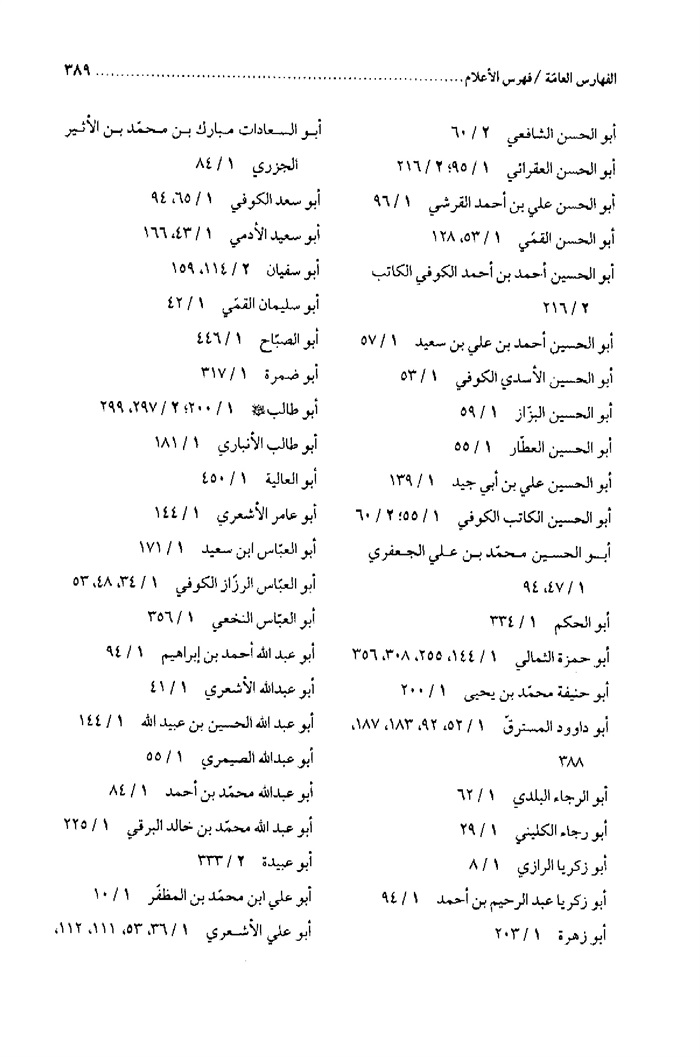
ص: 389
الصورة
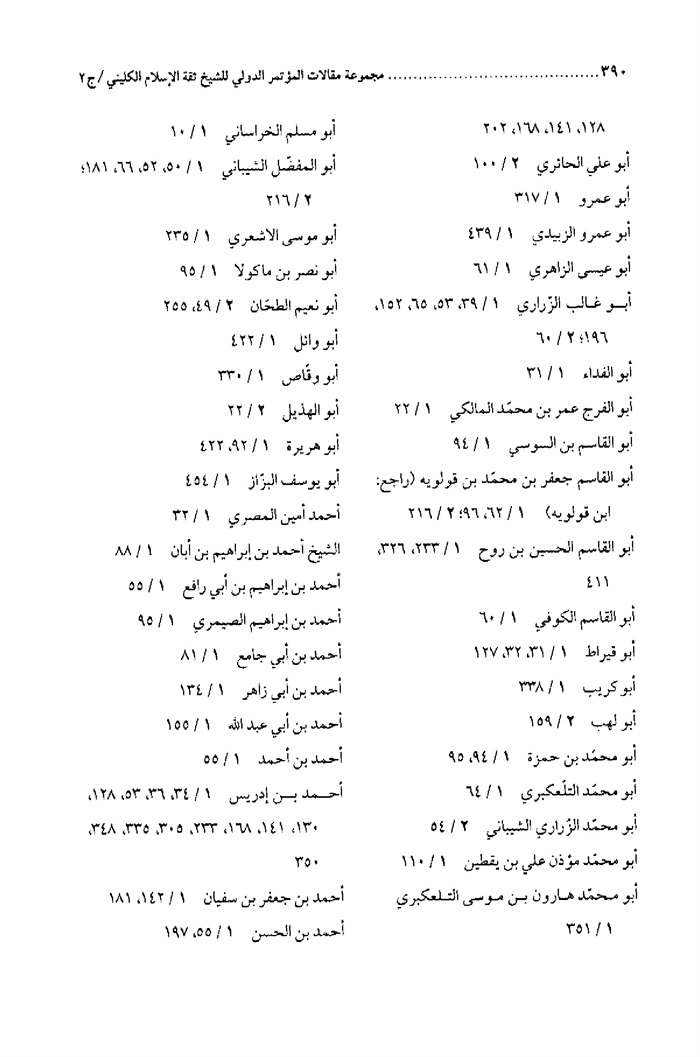
ص: 390
الصورة
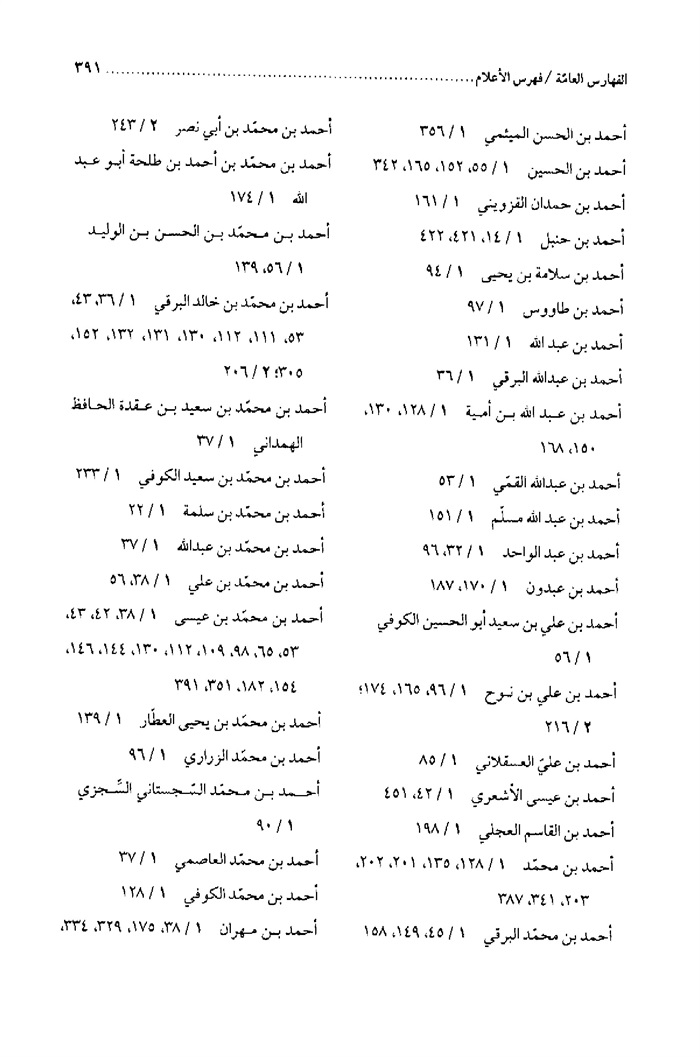
ص: 391
الصورة
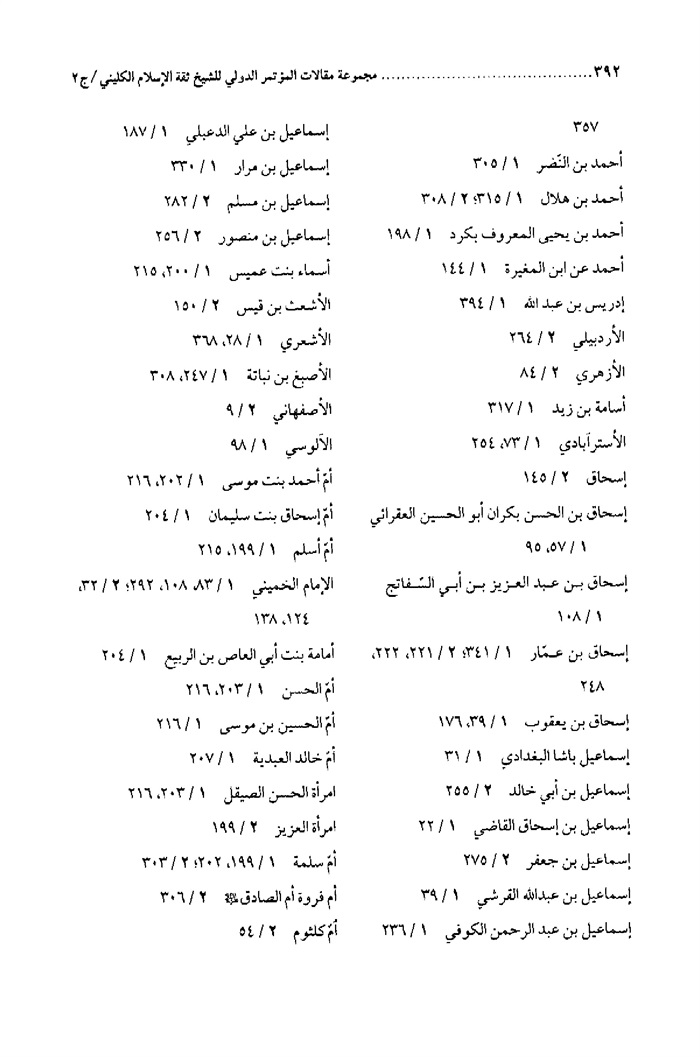
ص: 392
الصورة
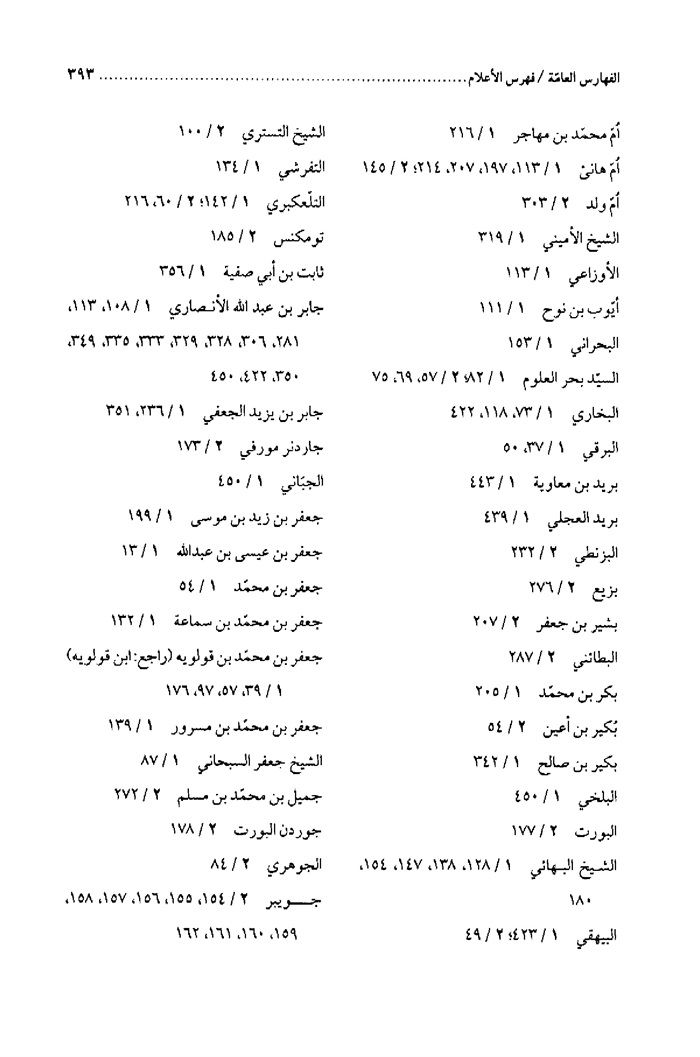
ص: 393
الصورة
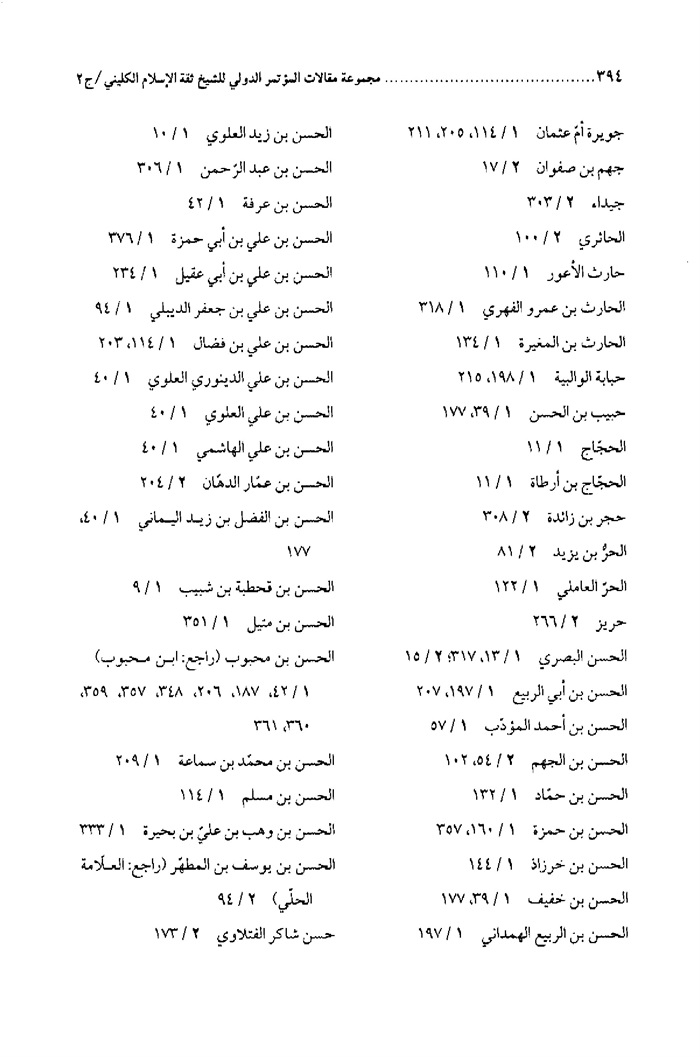
ص: 394
الصورة
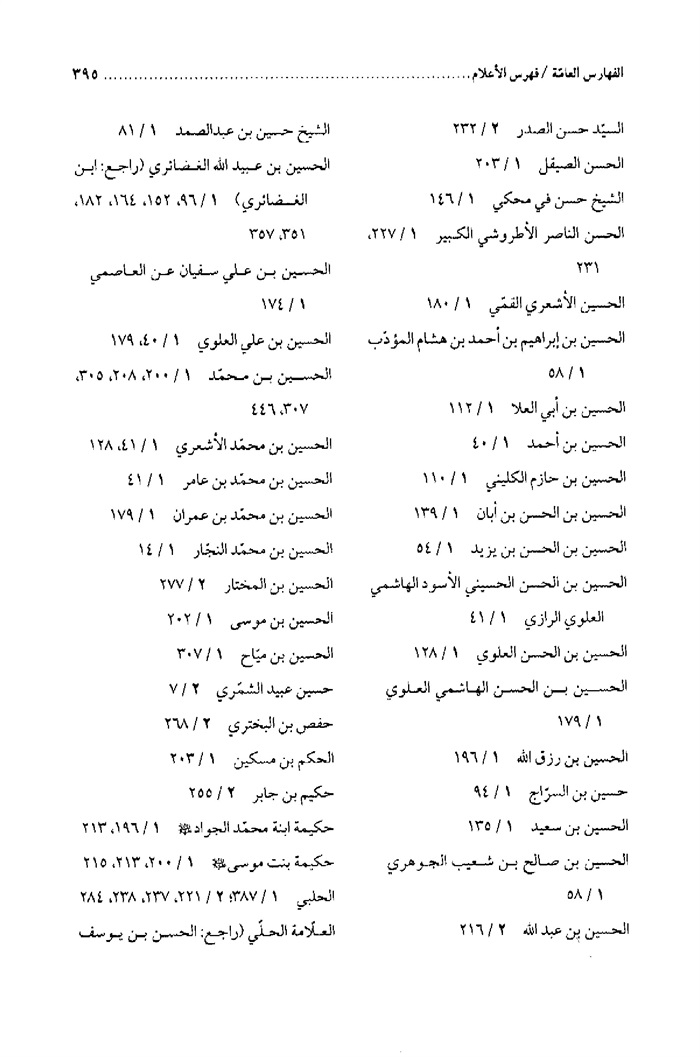
ص: 395
الصورة
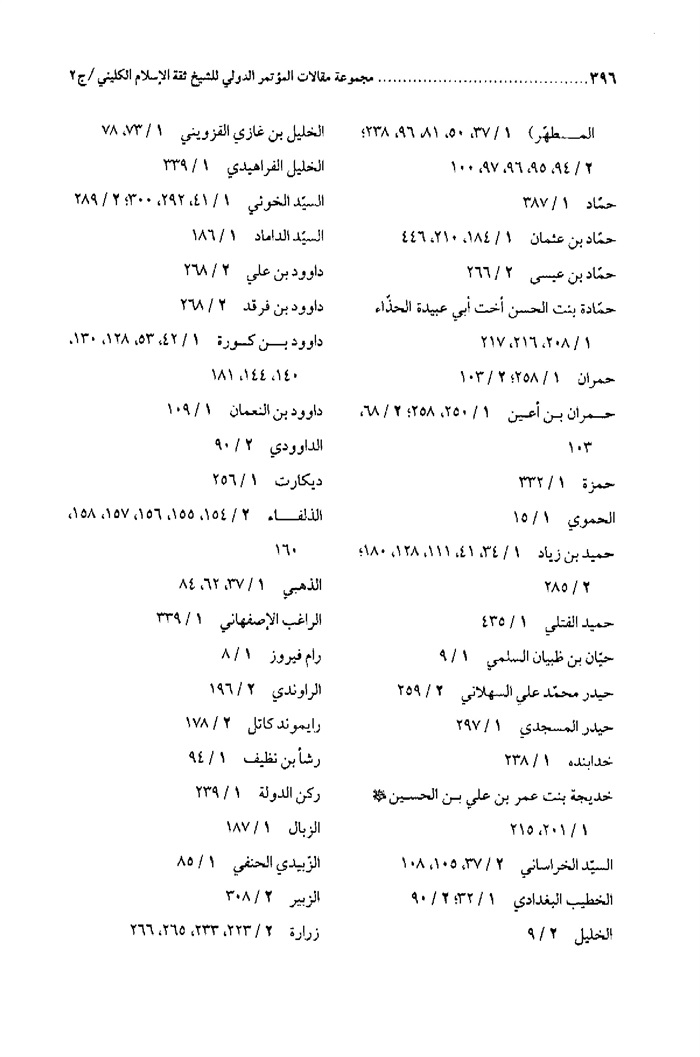
ص: 396
الصورة
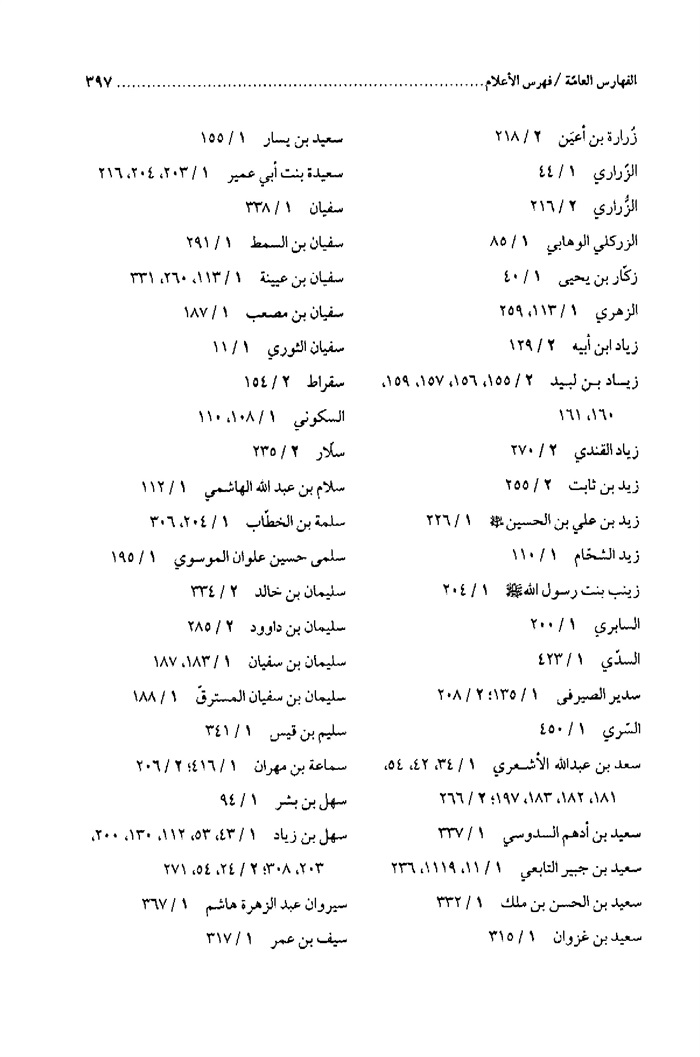
ص: 397
الصورة
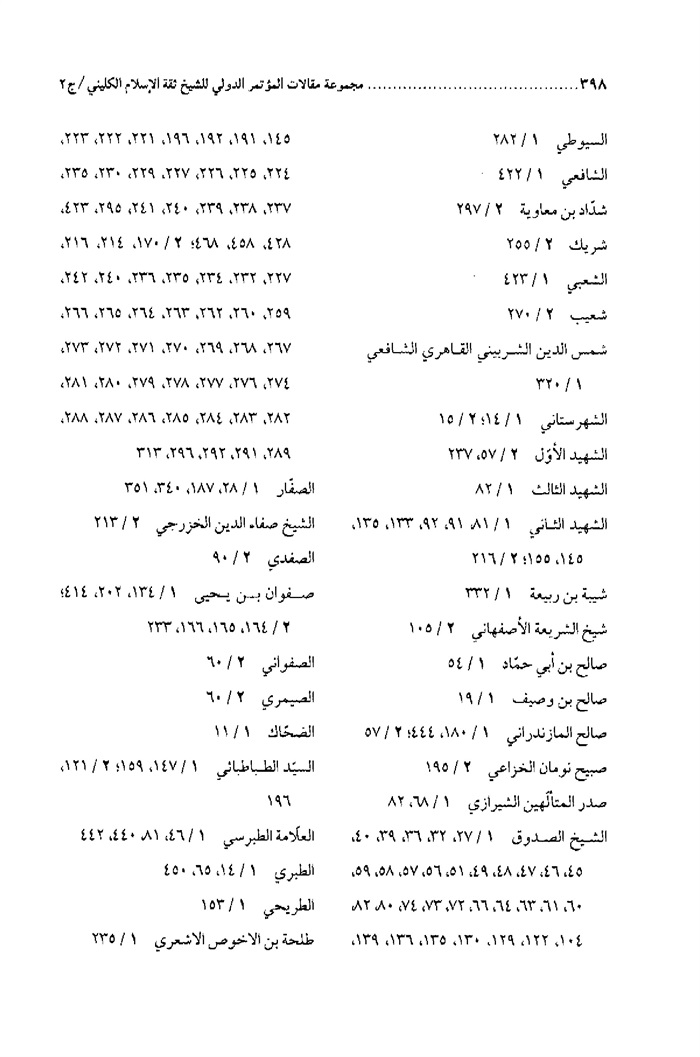
ص: 398
الصورة
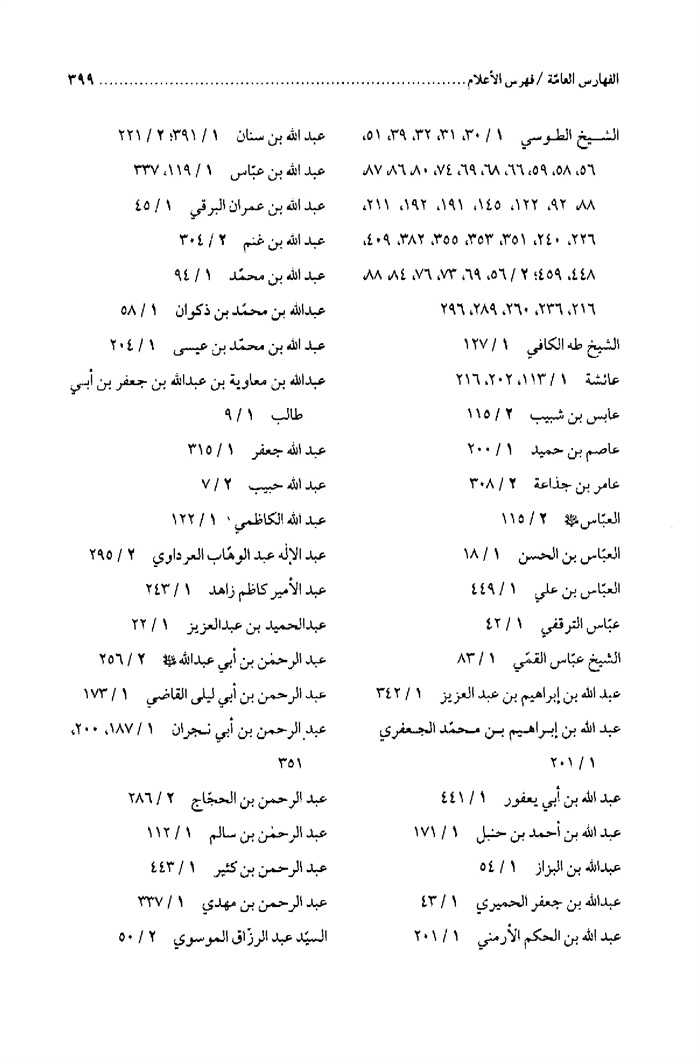
ص: 399
الصورة
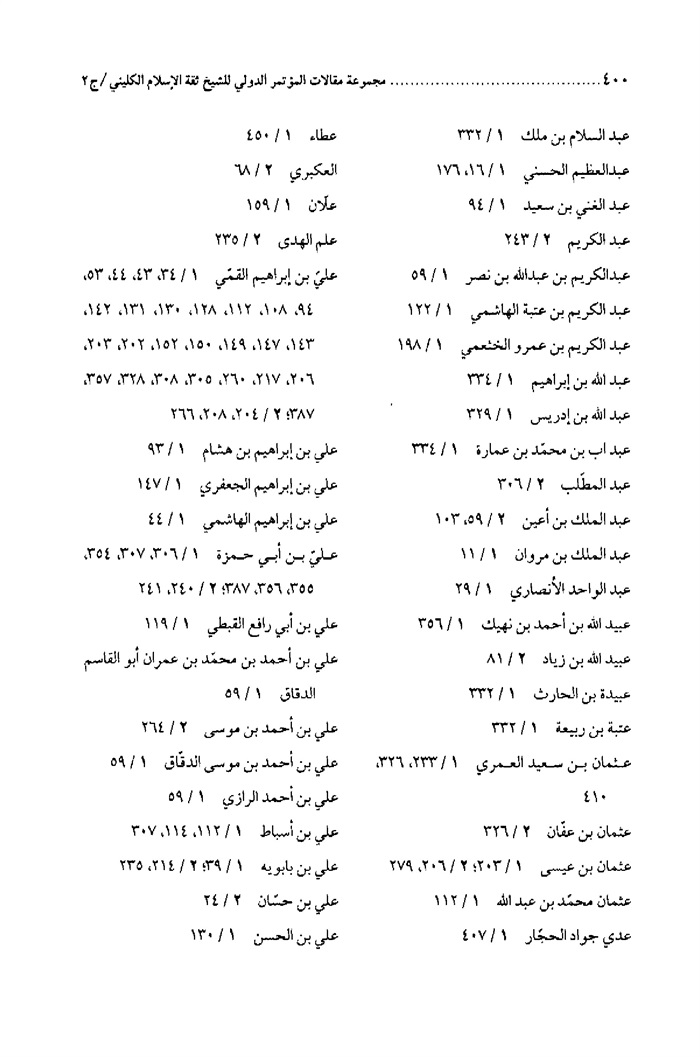
ص: 400
الصورة
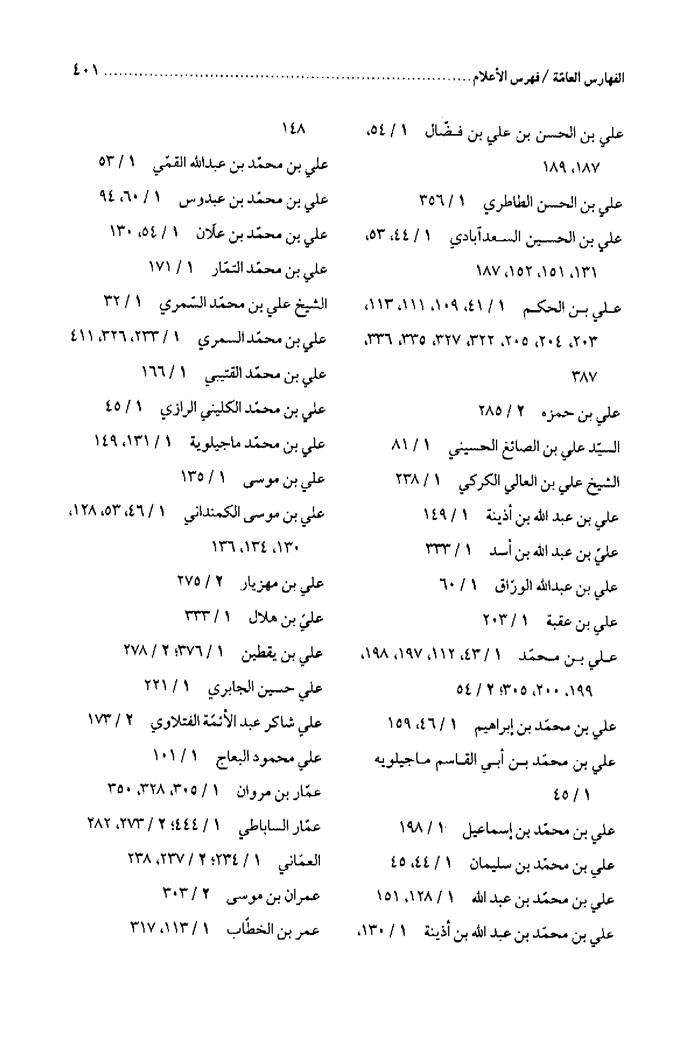
ص: 401
الصورة
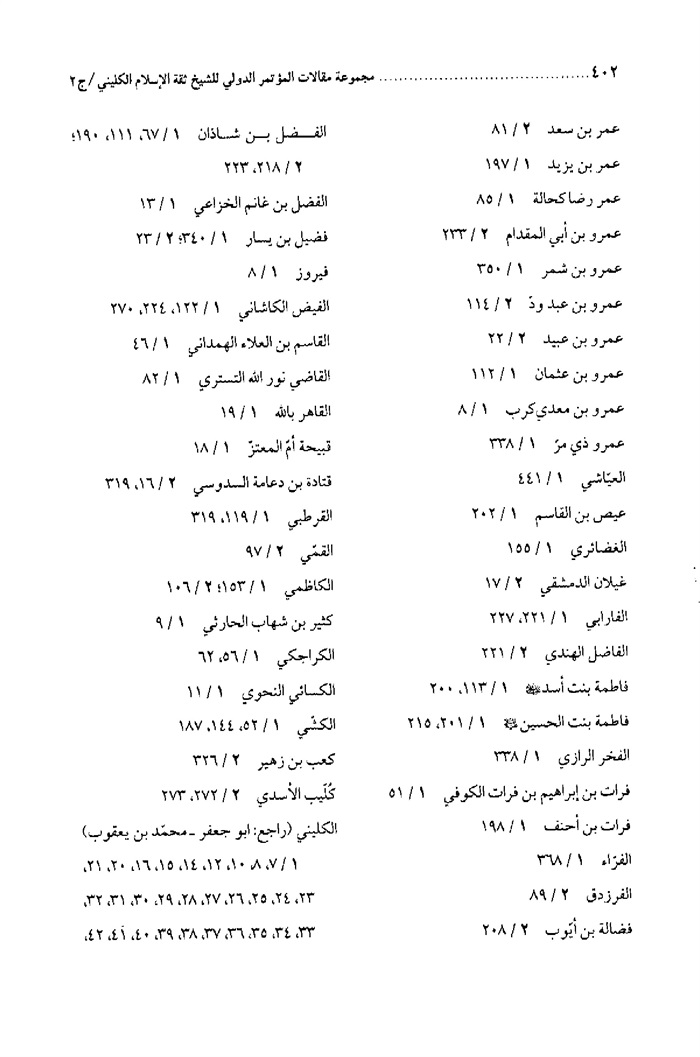
ص: 402
الصورة
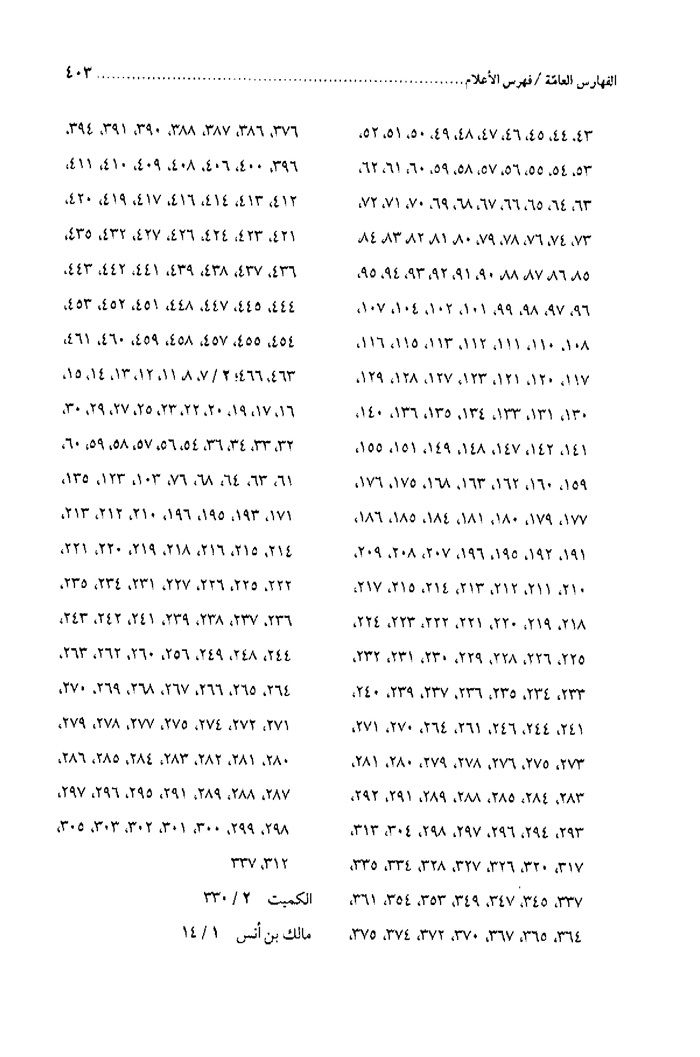
ص: 403
الصورة
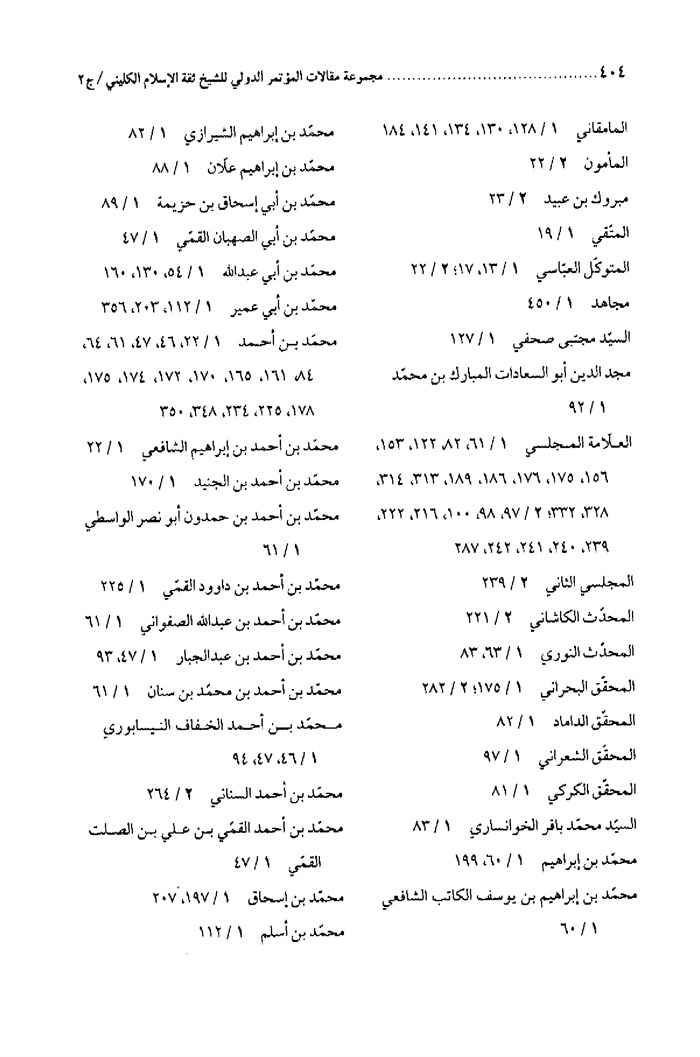
ص: 404
الصورة
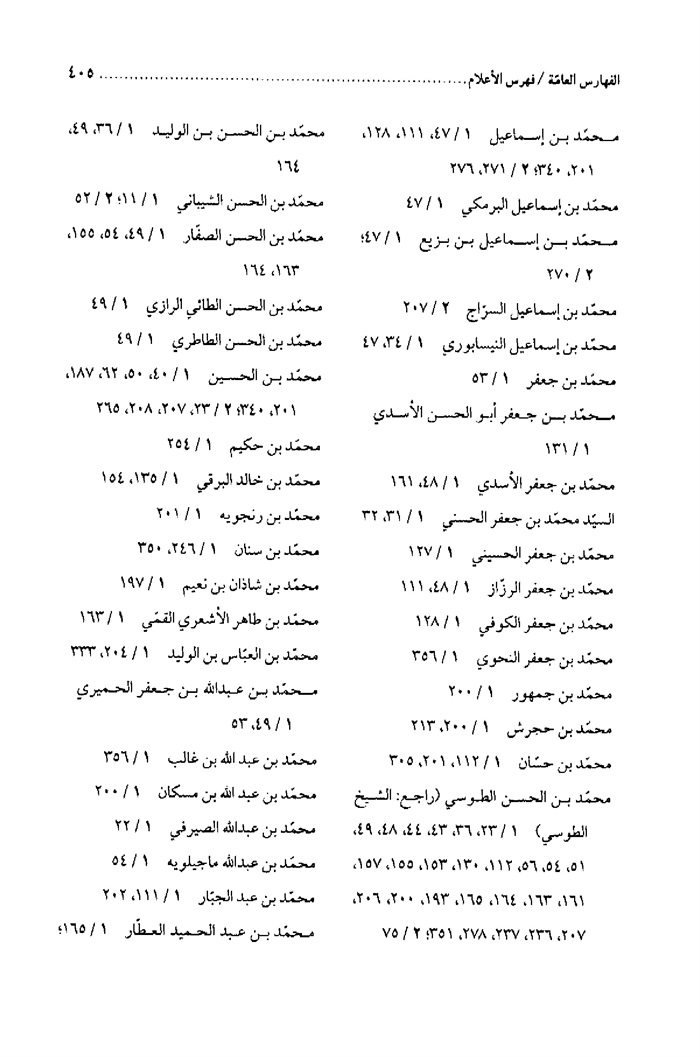
ص: 405
الصورة
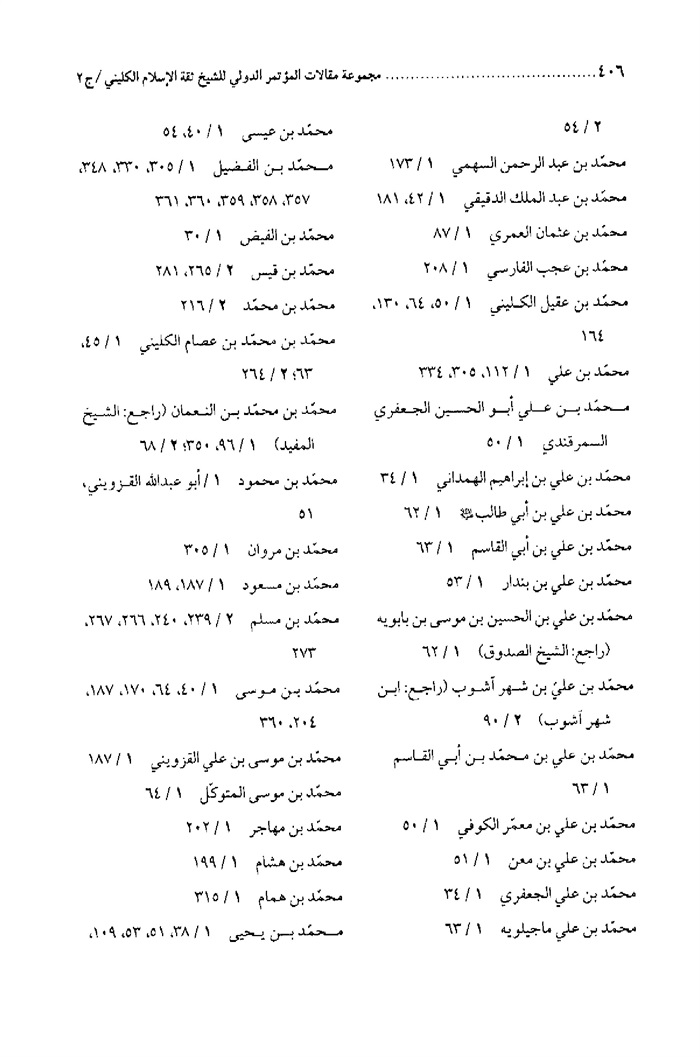
ص: 406
الصورة
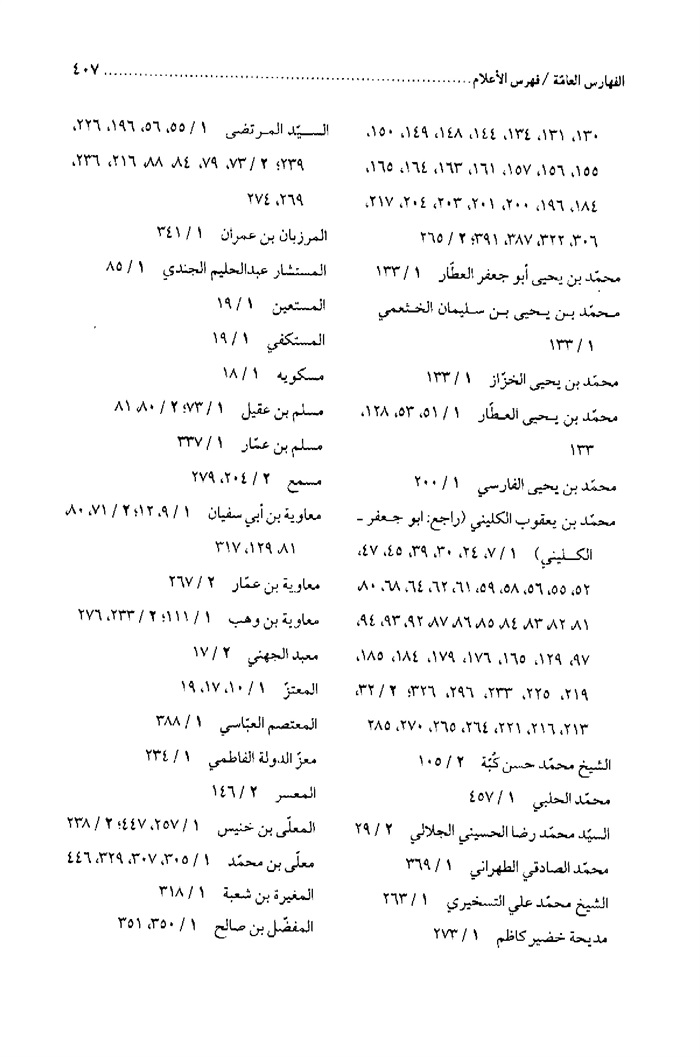
ص: 407
الصورة
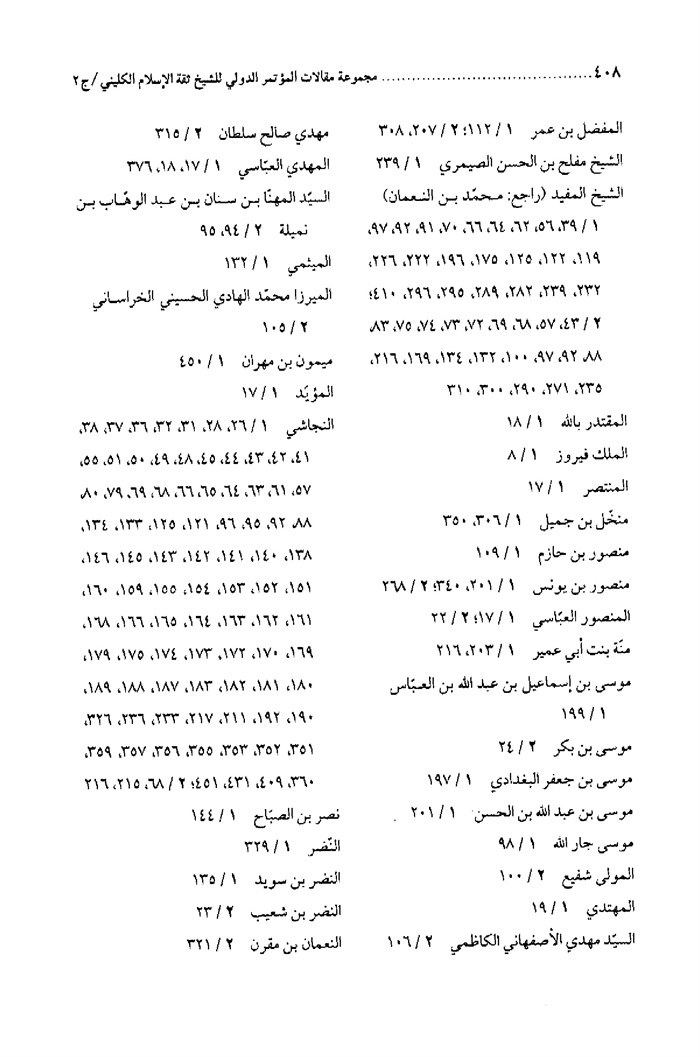
ص: 408
الصورة
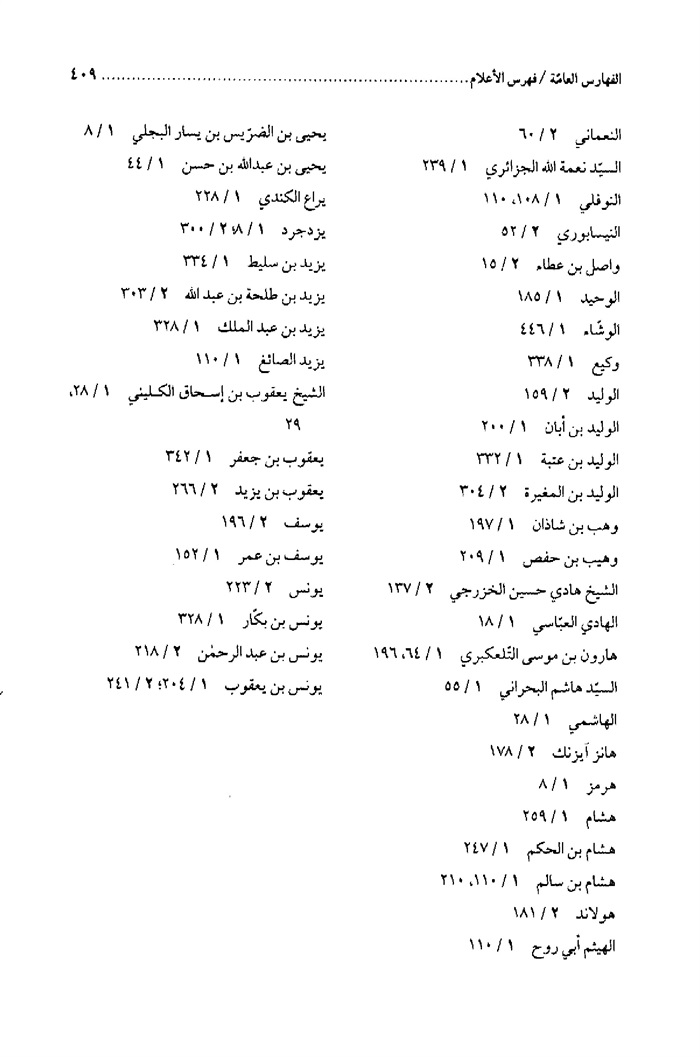
ص: 409
الصورة
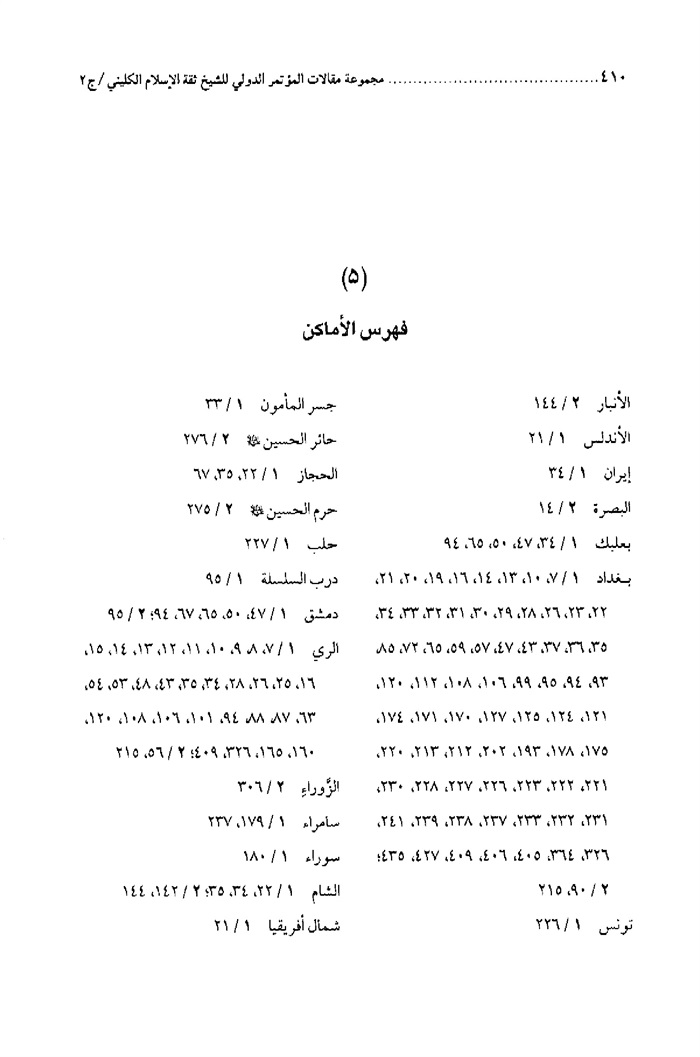
ص: 410
الصورة
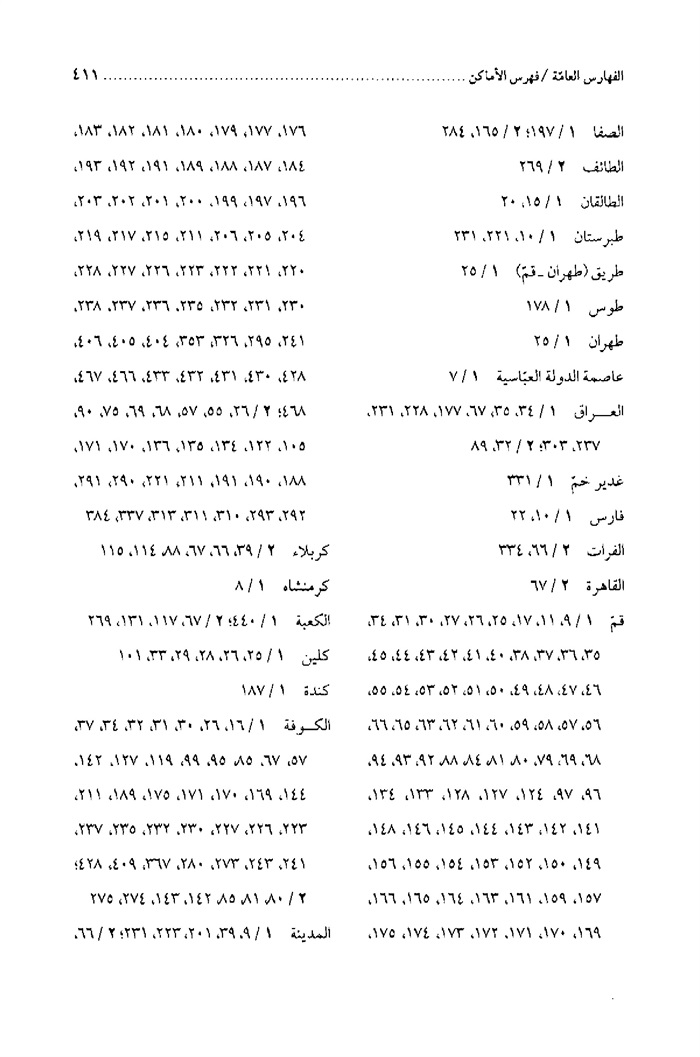
ص: 411
الصورة
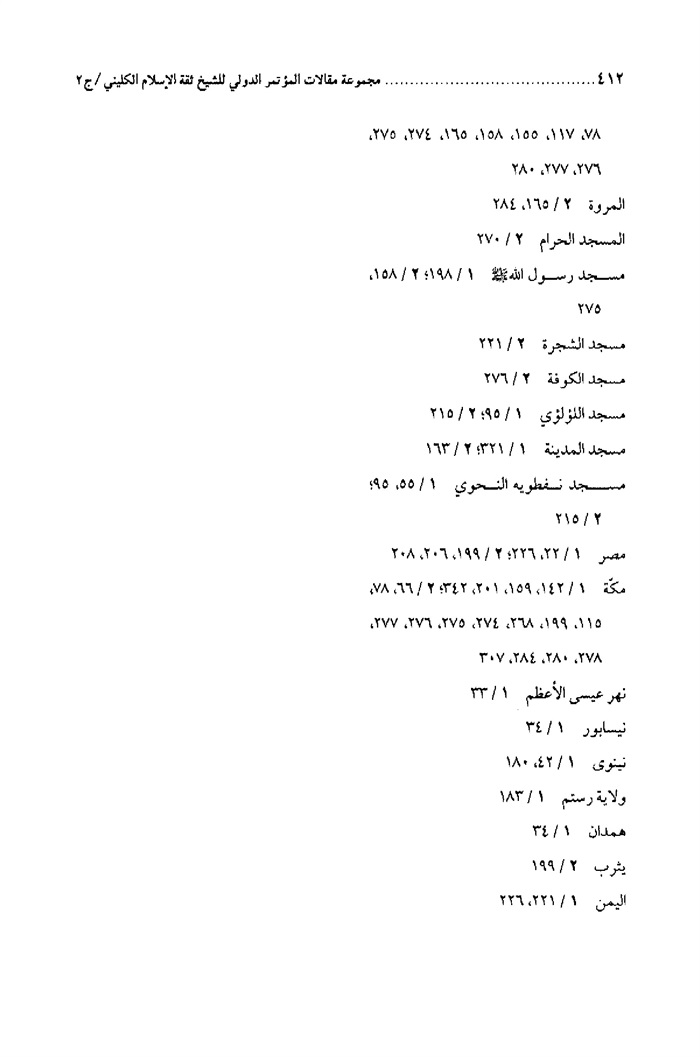
ص: 412
الصورة
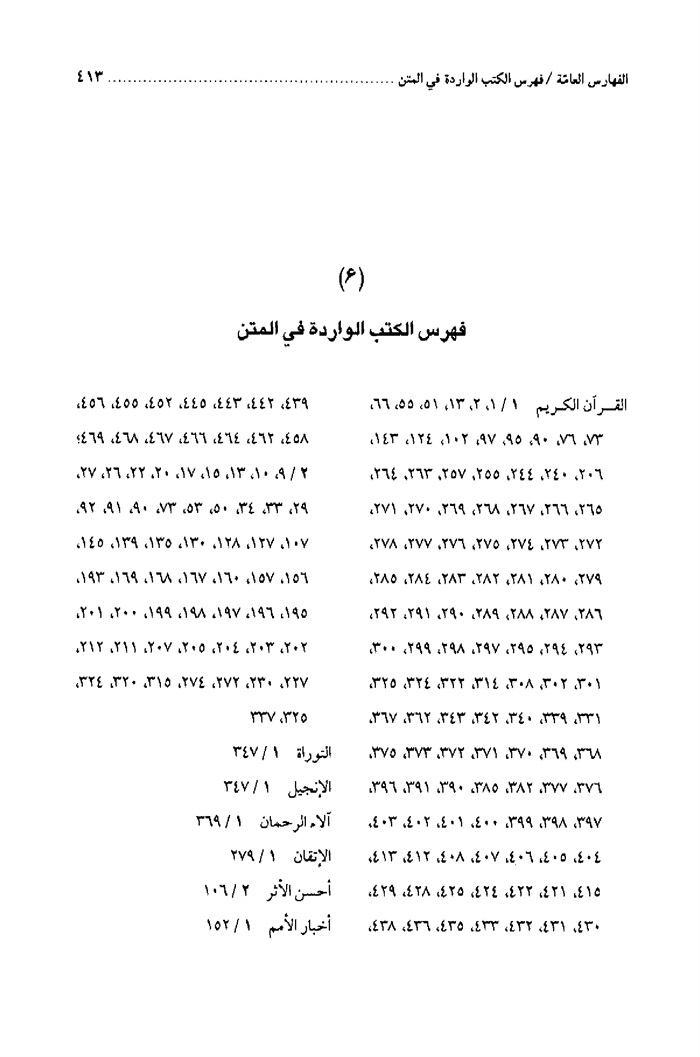
ص: 413
الصورة
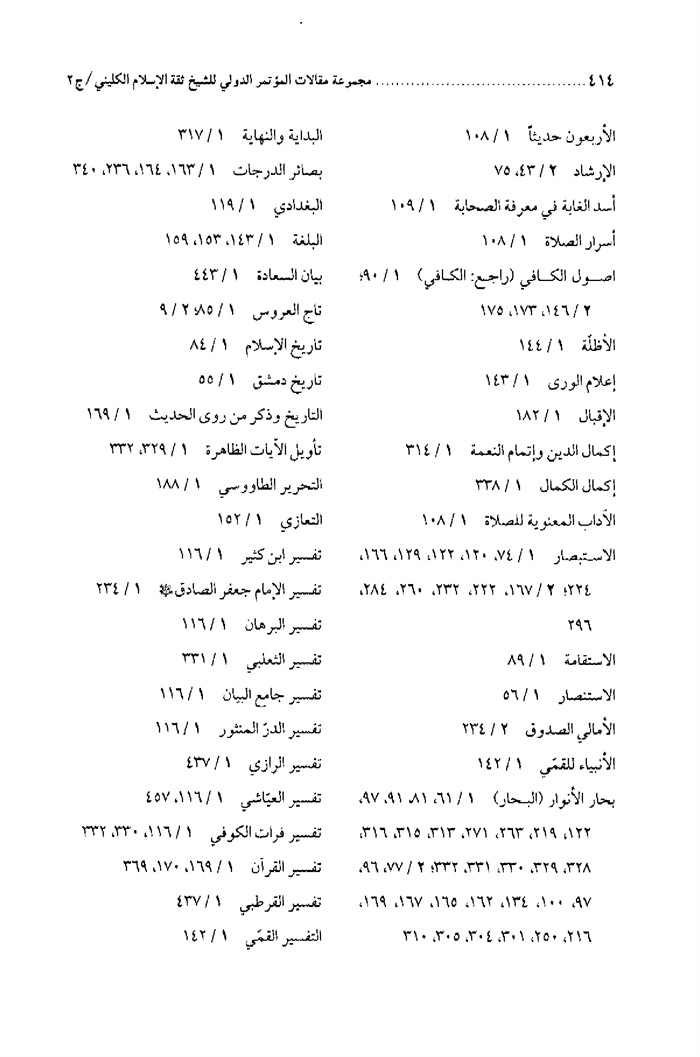
ص: 414
الصورة
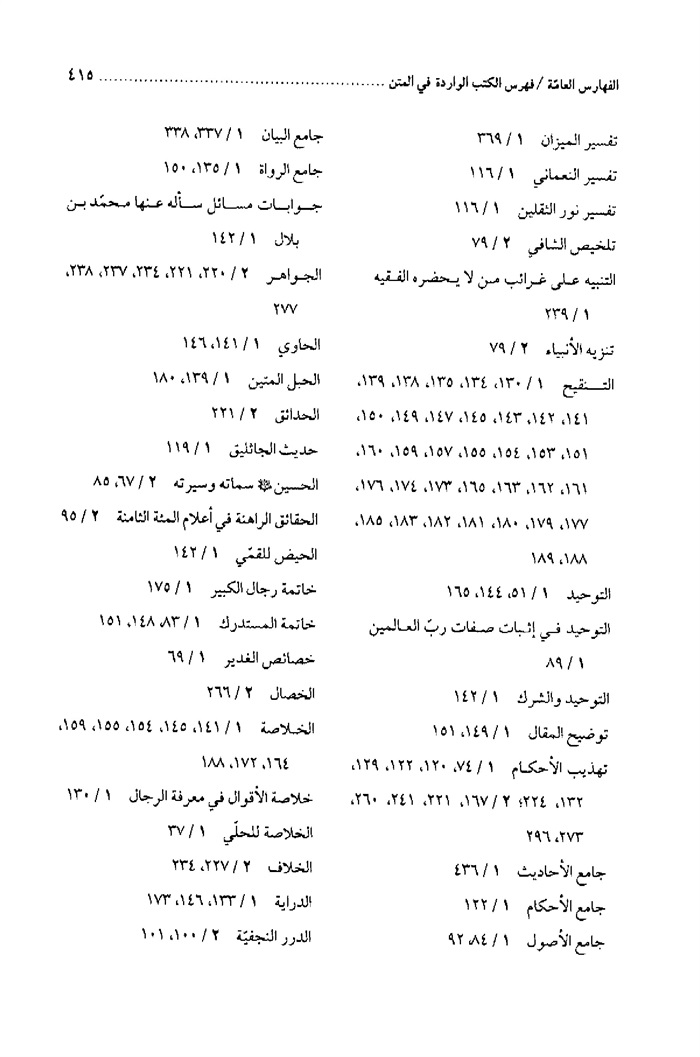
ص: 415
الصورة
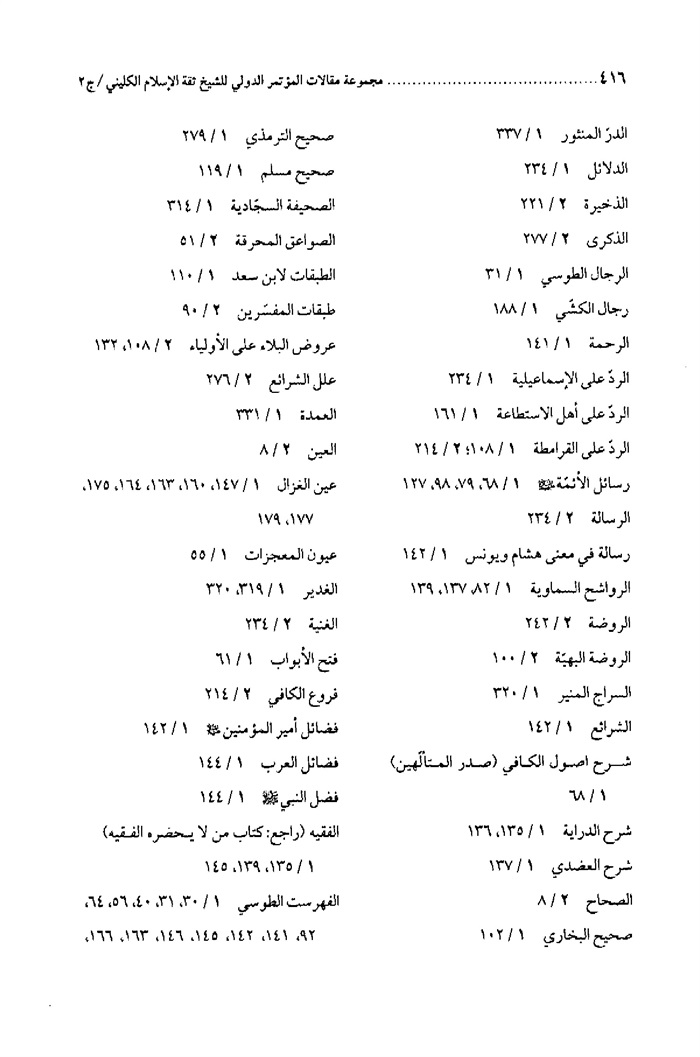
ص: 416
الصورة
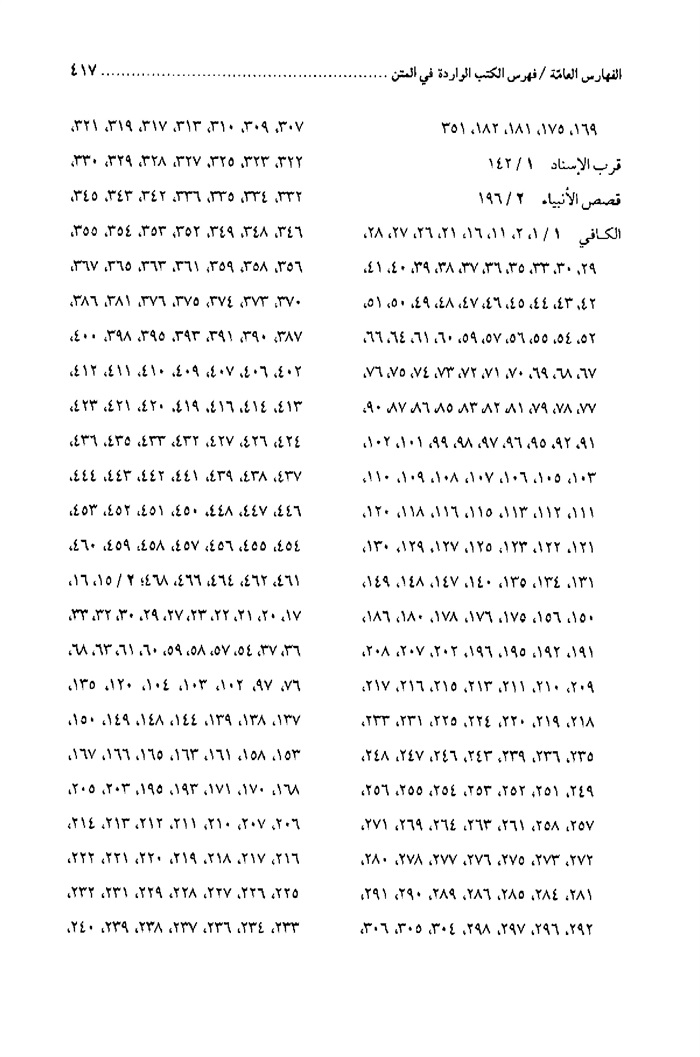
ص: 417
الصورة
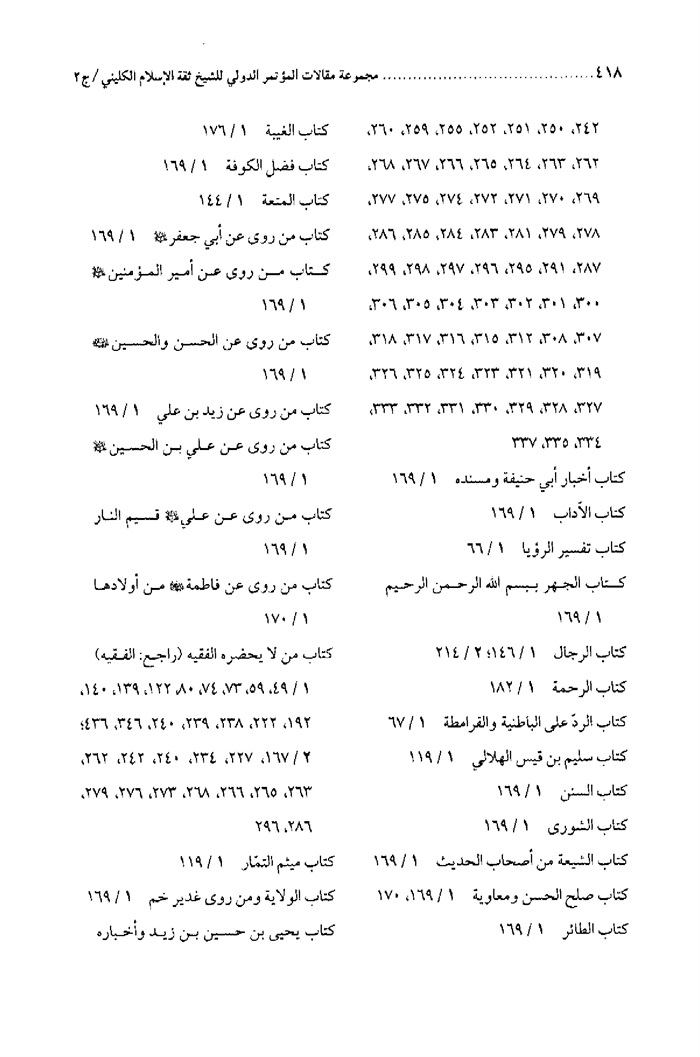
ص: 418
الصورة
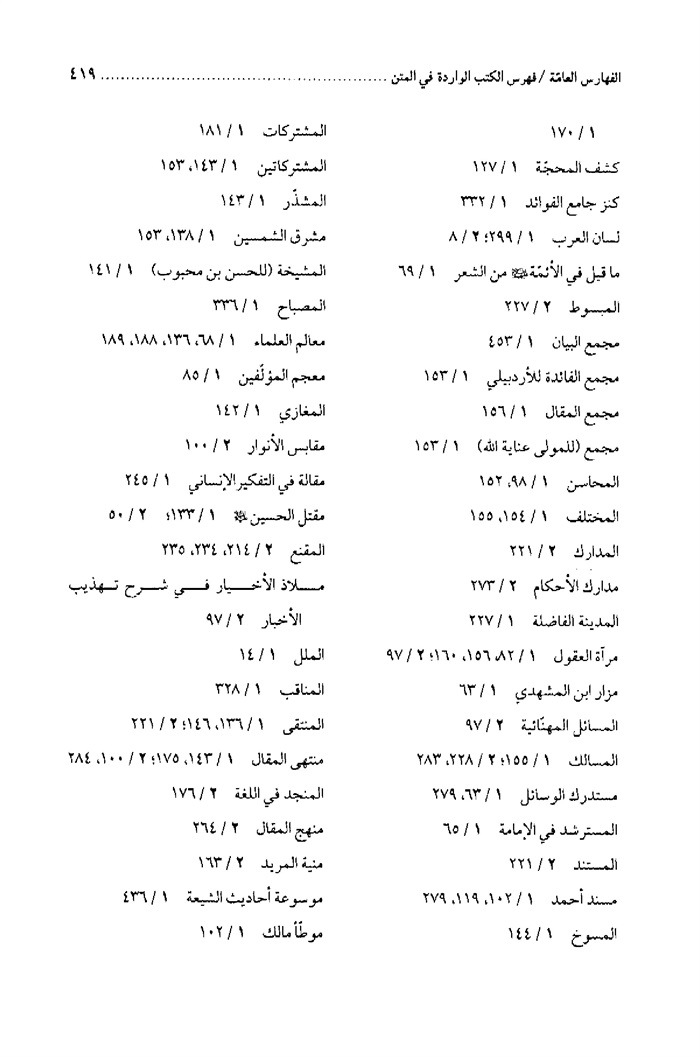
ص: 419
الصورة
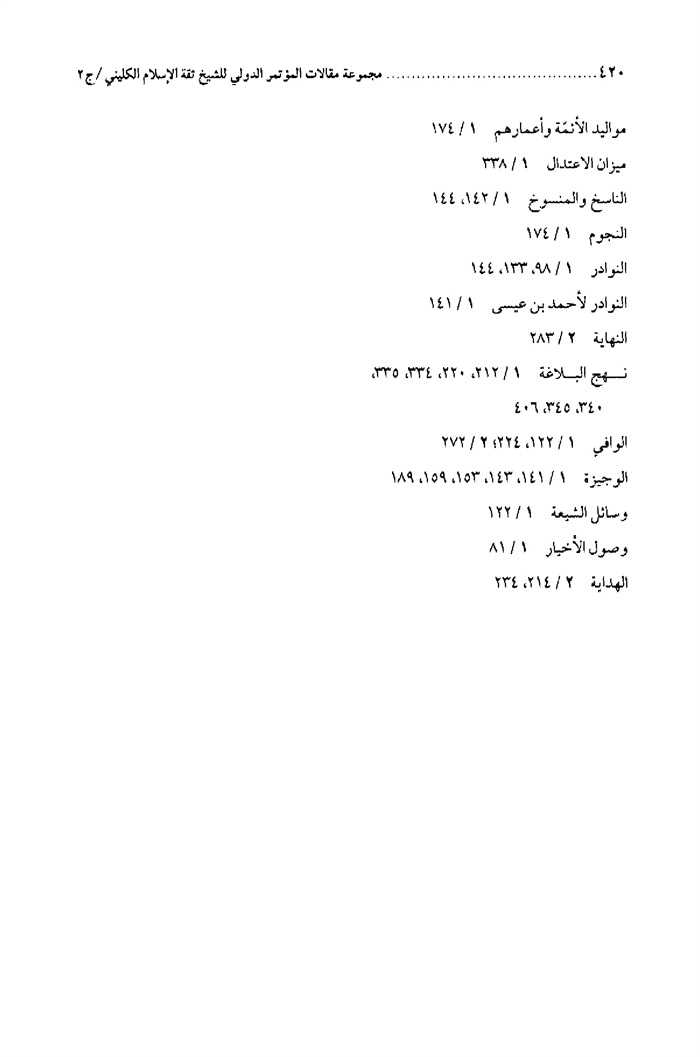
ص: 420
الصورة
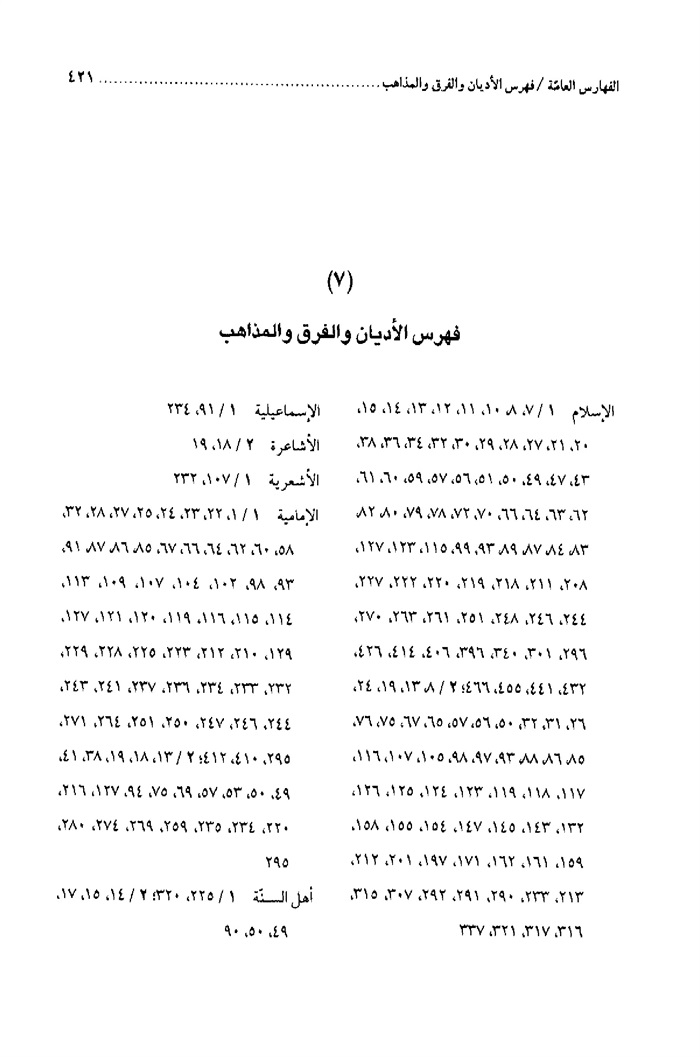
ص: 421
الصورة
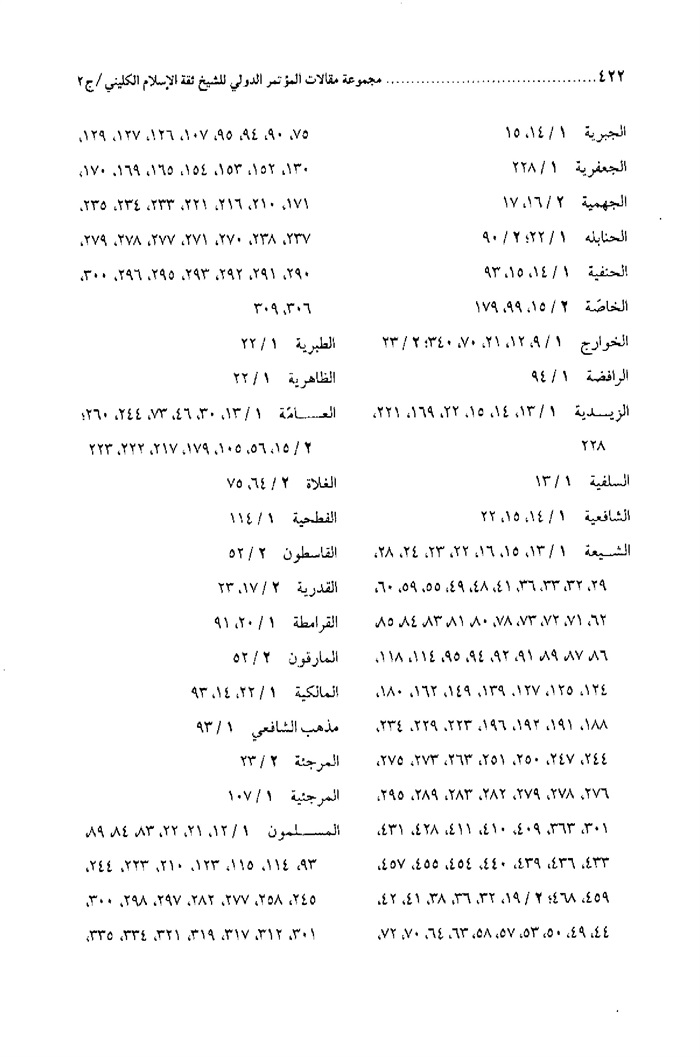
ص: 422
الصورة
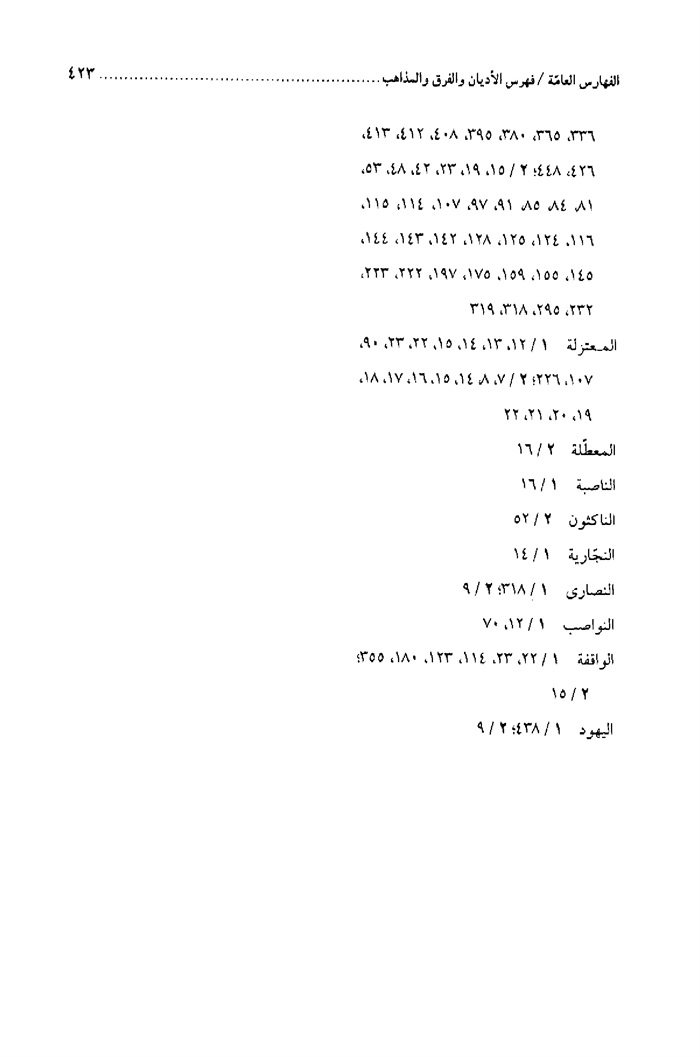
ص: 423
الصورة
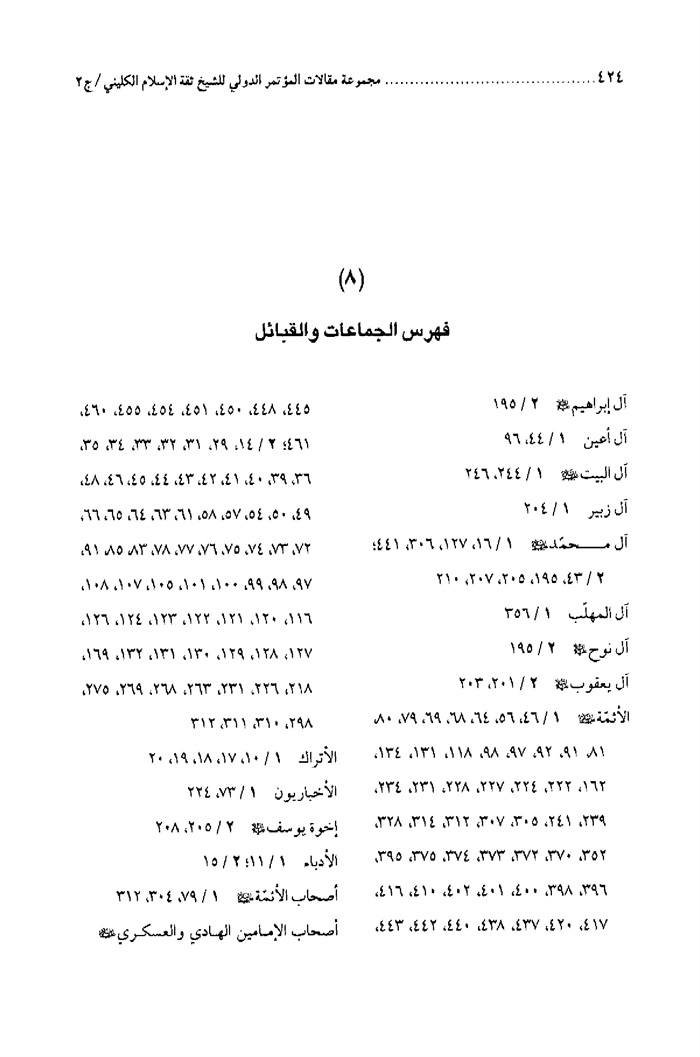
ص: 424
الصورة
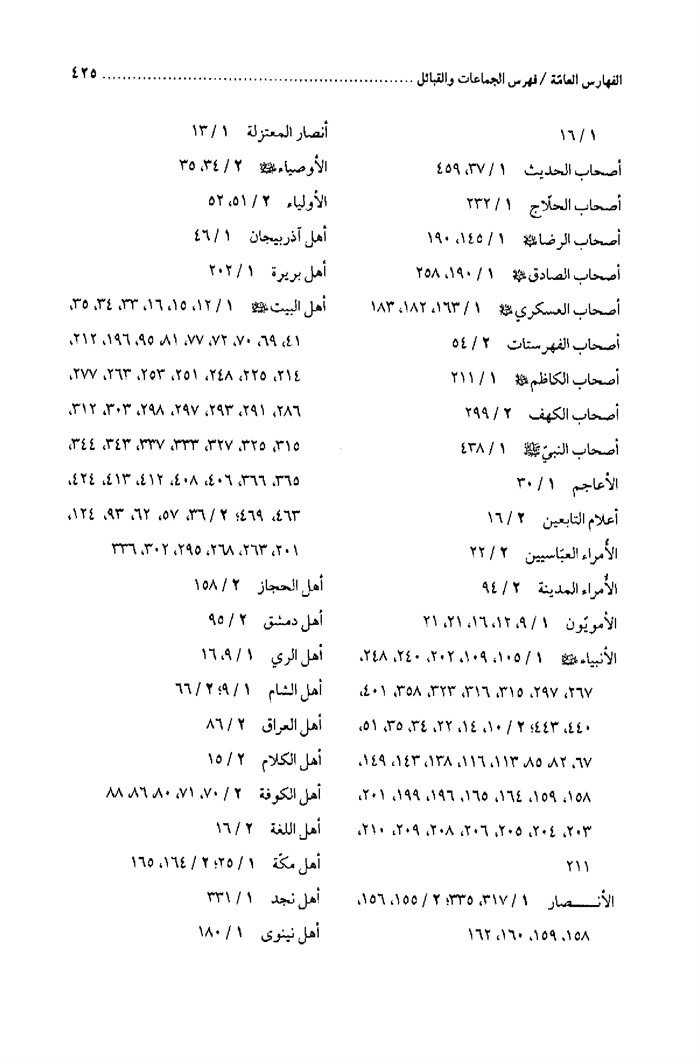
ص: 425
الصورة
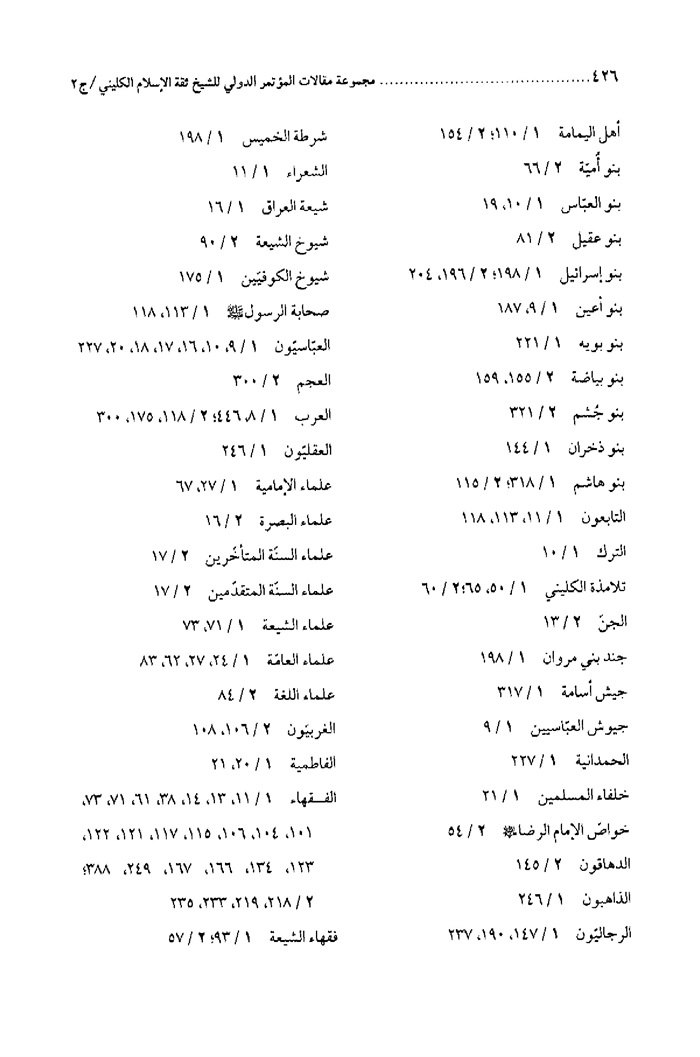
ص: 426
الصورة
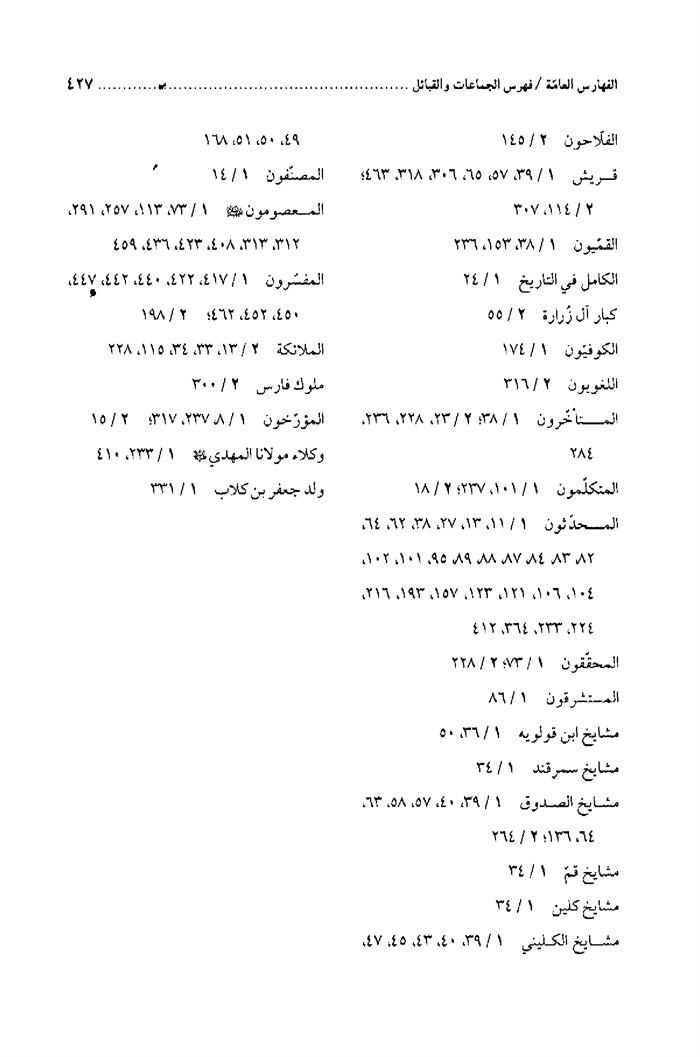
ص: 427
الصورة
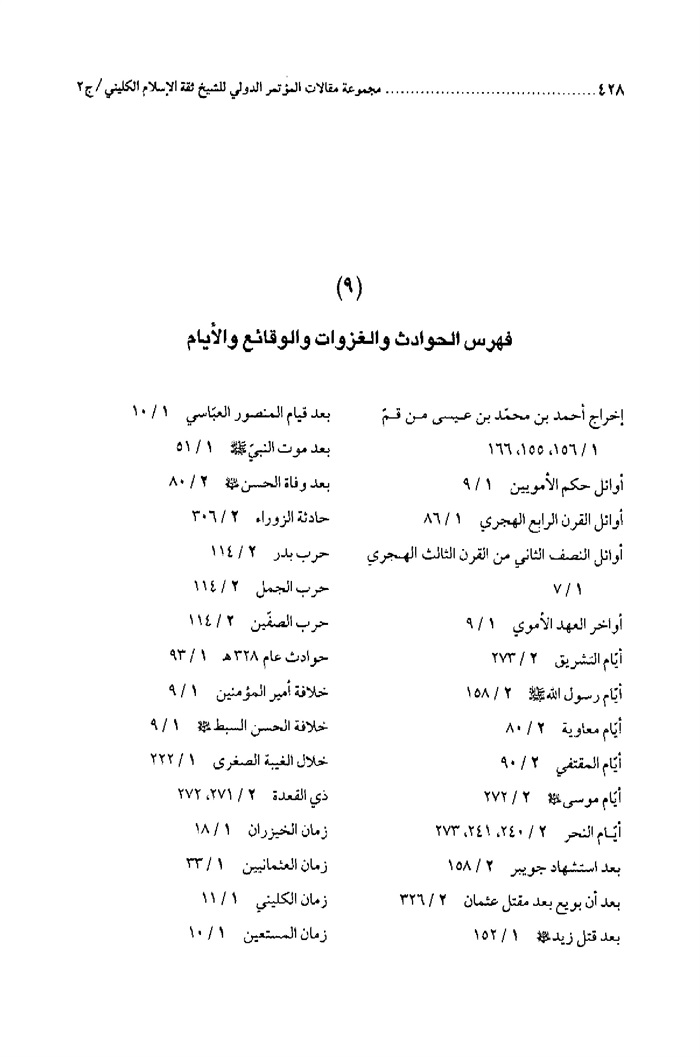
ص: 428
الصورة
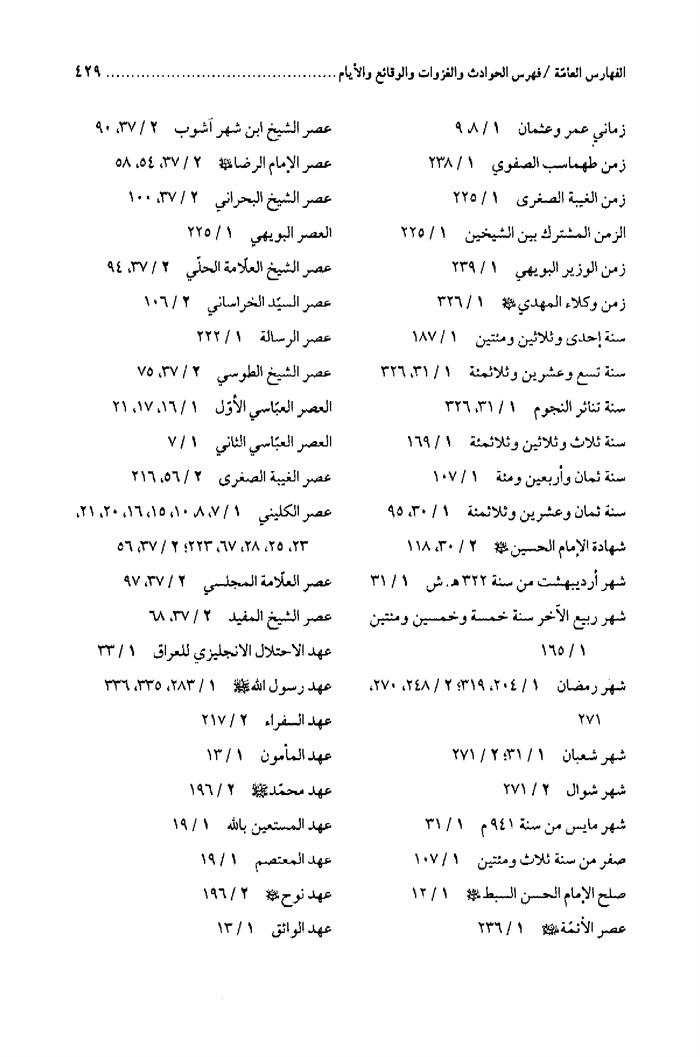
ص: 429
الصورة
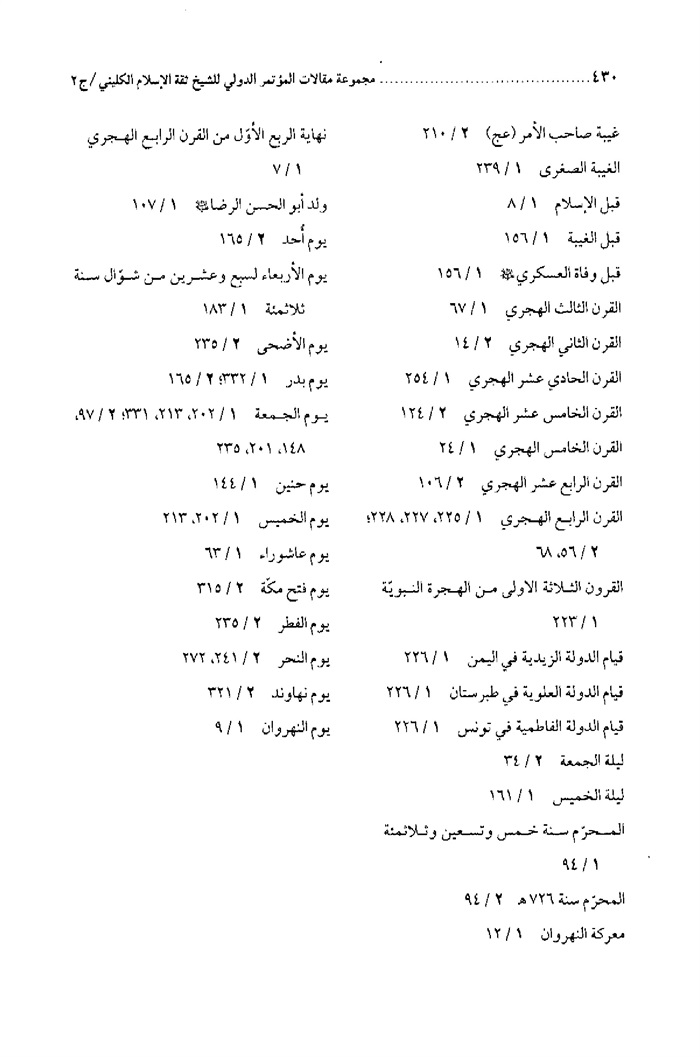
ص: 430
الفهرس الإجمالي 5
الآخر في فكر الكليني، المعتزلة أُنموذجا 7
المقدّمة 7
المبحث الأوّل: الآخر في اللغة والاصطلاح 8
الدراسات الدينية 11
المبحث الثاني: الآخر العقدي 14
الشرك والتوحيد 19
التوحيد في الصفات 20
المؤلّفة قلوبهم 24
الخاتمة 24
المصادر والمراجع 26
علم الأئمّة عليهم السلام بالغيب والاعتراض عليه بالإلقاء للنفس إلى التهلكة و... 29
الخلاصة 29
أصل المشكلة ووجه الاعتراض 37
الاعتراض الأوّل: 38
الاعتراض الثاني: 39
ص: 431
تحديد محور البحث بين الاعتراضين 40
الأمر الأوّل: 40
الأمر الثاني: 41
الأمر الثالث: 41
الأمر الرابع: 42
الأمر الخامس: 44
معنى الآية والمراد منها 47
الأمر السادس: 48
أهل السنّة ومسألة «علم الغيب» 50
صيغ المشكلة وأجوبتها عبر العصور 54
1 - عصر الإمام الرضا عليه السلام (ت 203 ه) 54
2 - عصر الشيخ الكليني (ت 329 ه) 56
3 - عصر الشيخ المفيد رحمه الله (ت 413 ه) 68
والجواب وباللّٰه التوفيق: 70
وأمّا بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام: 73
وبالنسبة إلى الإمام الحسن عليه السلام: 74
4 - عصر الشيخ الطوسي (ت 460 ه) 75
لكنّ هذا التصوّر خاطئٌ لوجوه: 77
مبيت عليّ عليه السلام على فراش الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ليلة الهجرة 78
حول شهادة الحسين عليه السلام 79
5 - عصر الشيخ ابن شهر آشوب (ت 588 ه) 90
6 - عصر الشيخ العلّامة الحلّي (ت 726 ه) 94
7 - عصر العلّامة المجلسيّ (ت 1110 ه) 97
ص: 432
* الأوّل: إنّ حفظ النفس ليس بواجب مطلقاً. 98
* الثاني: إنّ حكم العقل بوجوب حفظ النفس غير مسموعٍ ولا متّبعٌ . 98
* الثالث: عدم تسليم وجود حكم للعقل بوجوب حفظ النفس في مثل هذا المقام: 98
8 - عصر الشيخ البحراني (ت 1186 ه) 100
9 - القرن الماضي مع السيّد الإمام الهادي الخراساني (ت 1368 ه) 105
عُرُوضُ البَلاءِ على الأولياءِ 108
الأوّل: 109
الثاني: 109
الثالث: 109
الرابع: 110
الخامس: 110
السادس: 110
السابع: 111
الثامن: 111
التاسع: 112
العاشر: 112
الحادي عشر: 113
الثاني عشر: 113
الثالث عشر: 115
الرابع عشر: 116
الخامس عشر: 117
السادس عشر: 118
السابع عشر: 118
ص: 433
الثامن عشر: 119
التاسع عشر: 119
متمّ العشرين: 119
10 - وفي هذا العصر: 124
خلاصة البحث 126
المصادر والمراجع 133
قصص الكافي دراسة ونقد 137
مقدّمة وتمهيد 137
القصّة الاُولى: مفتاح الحلّ ، قرار العمل 139
القصّة الثانية: دعوة الحال 142
القصّة الثالثة: استقبال جاهلي! 144
القصّة الرابعة: الفقير الغني 146
القصّة الخامسة: أُسلوب في الاحتجاج 148
القصّة السادسة: السؤال الذي أجاب عنه السائل أخيراً 152
القصّة السابعة: جويبر والذلفاء 154
القصّة الثامنة: مجلس عالم وتشييع جنازة 162
القصّة التاسعة: السعي في حوائج الإخوان 164
نتائج بحث قصص «الكافي» وخلاصته 166
المصادر والمراجع 169
سمات الشخصية المؤمنة وأنماطها في فكر الإمام عليّ عليه السلام في كتاب أُصول الكافي... 173
مشكلة البحث وأهمّيته 173
أهداف البحث 175
حدود البحث 175
ص: 434
مفهوم سمات الشخصية 176
أولاً: مفهوم السمة في اللغة 176
ثانياً: طبيعة السمات 176
ثالثاً: منظور السمات مدخلاً لتفسير الشخصية الإنسانية 178
رابعاً: أنواع السمات 178
1 - على وفق كاتل «Cattell» هنالك أنواع أساسية من السمات، هي: 179
2 - السمات والخاصّة 179
3 - السمات السطحية والأساسية 179
4 - السمات أحادية القطب مقابل ثنائية القطب 180
5 - السمات ثنائية القطب 180
خامساً: أنماط الشخصية 180
منهجية البحث 181
أ. سمات الشخصية المؤمنة العقلية والفكرية 183
ب. سمات الشخصية المؤمنة الانفعالية والوجدانية والمزاجية 184
ج. سمات الشخصية المؤمنة الاجتماعية 185
د. سمات الشخصية المؤمنة الأخلاقية والعبادية 187
ه. السمات النفسية العامّة للشخصية المؤمنة 189
و. السمات العلمية والاقتصادية للشخصية المؤمنة 190
ز. فيما يلي جدول عام يوضّح أعداد السمات كلّها ونسبتها المئوية. 191
نتائج البحث واستنتاجاته 192
المصادر والمراجع 193
بلاء يوسف عليه السلام في الكافي ونجاته بآل محمّد عليهم السلام مرويات الكافي (مستنداً) 195
المقدّمة 195
ص: 435
المبحث الأوّل 196
أوّلاً: أغراض وأبعاد القصص القرآني 196
ثانياً: مواصفات قصّة يوسف 199
سبب بلاء يوسف عليه السلام 201
المبحث الثاني: مشاهد قصّة يوسف. 202
أوّلاً: مشهد الرؤيا. 202
ثانياً: مشهد الإلقاء في غيابة الجبّ . 203
ثالثاً: مشهد عودة بنيامين لأخيه يوسف عليه السلام 206
رابعاً: مشهد قميص يوسف 207
انتقال القميص من إبراهيم إلى آل محمّد عليهم السلام 207
مشهد لقاء يوسف وعتابه لإخوته على ما سلف منهم. 208
الخاتمة 210
المصادر والمراجع 211
دراسة حول الأبعاد الفقهية في تراث الشيخ الكليني 213
وقفة قصيرة مع كتاب «الكافي» 214
الملامح العامّة للبعد الفقهي 217
1 - بيان الفتوى على ضوء الأخبار والاستدلال عليها 218
2 - الجمع بين الأخبار المتعارضة 219
3 - عنايته بالأقوال 222
4 - البحث الاستدلالي في بعض البحوث الهامّة 225
الملامح العامّة للبعد الأُصولي عند الكليني 226
1 - الأدلّة 226
2 - حجّية الظواهر 230
ص: 436
3 - حجّية خبر الآحاد 230
4 - التعارض 231
آراؤه الفقهيّة التي انفرد بها 232
الدليل: 233
الطهارة، وظيفة الحائض 239
الصلاة، قضاؤها 239
الحجّ ، تروكه 240
أيّام النحر 240
النكاح 241
العقيقة 241
تراثه الفقهي 243
الوضوء 243
الصلاة 243
1 - وقت صلاة المغرب 243
2 - التطوّع في وقت الفريضة 244
3 - أحكام الخلل 244
الصوم 248
الحجّ ، وقت التلبية 248
الخمس والأنفال، الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 249
كتاب المواريث 250
1 - باب وجوه الفرائض 250
2 - باب بيان الفرائض في الكتاب 251
ص: 437
3 - ميراث الجدّ والجدّة 256
الديات، القسامة 256
بحوث فقهية، المباني الفقهية للمحدّثين في ضوء كتاب الكافي... 259
المقدّمة 259
أوّلاً: المبنى الفقهي 261
ثانياً: المبنى الفقهي للشيخين 261
ثالثاً: طريق الشيخ الصدوق إلى الكليني 264
الفصل الأوّل: المباني المتوافقة 264
الفصل الثاني: المباني المتعارضة 274
المصادر والمراجع 290
أشعار الكافي دراسة تحليلية 295
1 - الجانب اللغوي 297
2 - الجانب التاريخي 299
3 - الجانب الأخلاقي 301
4 - الجانب الاجتماعي 303
5 - الجانب الحربي 305
6 - الجانب الوضعي 308
المصادر والمراجع 309
مختارات من نوادر «روضة الكافي» للكليني 315
«وبثقا علينا بثقاً في الإسلام لا يُسكرُ أبداً» 316
«احذر أن تكون سبب بليّةٍ على الأوصياء أو حارشاً عليهم بإفشاء ما استودعتُك» 317
«من حقّرهُم [المساكين]... فإنّ اللّٰهُ لهُ حاقر ماقت» 318
ص: 438
«أخائبُ خلق اللّٰه» 319
«الأشقى على رُثُوثة» 320
«زبرتُموهُم ونهيتُموهُم» 321
«زمّ نفسهُ من التّقوى بزمامٍ » 322
«ومن أظلمُ عند اللّٰه ممّن استسبّ للّٰهِ ولِأولياءِ اللّٰهِ » 324
«لولا أنّ اللّٰه يدفعُهُم عنكُم لسطوا بكُم» 325
«لتُساطُنّ سوطة القدر» 326
«لمّا استتمُّوا الأُكلة أخذهُمُ اللّٰهُ واصطلمهُم» 327
«من هذا ضغث ومن هذا ضغث» 328
«هل هي إلّاكلُعقة الآكل... ثُمّ تُلزمُهُمُ المعرّاتُ » 329
«أُغرقُ نزعاً ولا تطيشُ سهامي» 330
«رضي بقُوته... وبما يستُرُ عورتهُ ، وما أكنّ به رأسهُ » 331
«إيّاكُم ومُماظّة أهل الباطل» 332
«واللّٰه ما كتمتُ وشمةً » 333
«أفلا أوقرتُمُوهُ حديداً؟» 334
وهذه أمثلة أُخرى لأساليب نادرة أيضاً 335
المصادر والمراجع 337
11. الفهارس العامّة 339
12. فهرس الآيات 341
13. فهرس الأحاديث 359
14. فهرس الأشعار 378
15. فهرس الأعلام 382
ص: 439
16. فهرس الأماكن 410
17. فهرس الكتب الواردة في المتن 413
18. فهرس الأديان والفرق والمذاهب 421
19. فهرس الجماعات والقبائل 424
20. فهرس الحوادث والغزوات والوقائع والأيام 428
ص: 440