الفهرست
الصورة

ص: 145
الإنفاق في سبيل الله
المؤلف: عز الدين بحر العلوم
الناشر: دار الزهراء
الطبعة: 0
الموضوع : الأخلاق
تاريخ النشر : 1408 ه-.ق
الصفحات: 194
نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
ص: 1
ص: 2
المجموعة الکاملة لمؤلفات الشهيد سماحة آية الله السيد عز الدين بحر العلوم (رحمه الله)
(11)
الإنفاق في سبيل الله
الشهيد السعيد سماحة آية الله السيد عز الدين بحر العلوم (رحمه الله)
مبّره
المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الثقافية الخيرية
دار الزهراء
للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان
ص: 3
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولی
2011 م - 1432 ه
دارالزهراء
للطباعة والنشروالتوزيع
--------------
بيروت - لبنان - حارة حريک - شارع المقداد - بناية الهدی
هاتف : 727764 3 00961 - 554094 1 00961
e-mail:najaf_86@yahoo.com
ص: 4
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
ص: 5
ص: 6
بسم الله الرحمن الرحيم
( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(1).
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)(2).
مشكلة الفقر ، والفقير لا تقل خطورة عن بقية المشاكل التي تهدد كيان المجتمع و تنخر فيه ، ولذلك تصدى الاسلإِم لها ، فأولاها اهتماماً خاصاً ، فوضع لها حلولاً دقيقة ليجنب الافراد ويلات الفقر ، فإن البطون أذا جاعت ، و الحاجة أذا الحت فقد يخرج الإنسان عن طوره ، ويصبح كالوحش الكاسر لا تقف أمامه أي عقبة من العقبات.
لقد تناول المشرع الإسلامي هذه المسأله فرسم لها الخطوط العريضة واعتمد فيها على الأسس الرصينة ليخفف بذلك الضغط عن الطبقات الضعيفة بأن جعل لهم حقأ في أموال الأغنياء .. ويتمثل هذا الحق بجعل الضرائب الإلزامية و النفقات التطوعية كما سنجد ذلك بنحو من التفصيل في بحوث هذا الكتاب مستمداً من القرآن الكريم و من السنة الشريفة.
وبتطبيق هذا القانون لم يبق فقير يعاني ما يخلفه الفقر من مصاعب وحرمان.
وموضوع بحثنا ليس هو الفقير المتوسل الذي يتخذ التكفف حرفة ومكسباً يكيف به حياته اليومية يلاحق الناس بيد ممدودة من شارع إلى آخر ، ومن زقاق إلى زقاق.
ليس هذا الإنسان موضوع بحثنا لأنه إنسان لايستحق أن يبحث عن مشكلته ، بل موضوع بحثنا هو الفقير العاجز عن العمل ، أو القادر الذي لم تساعده الضروف على حصول عمل يؤمن له معاشه ، أو من يعول به.
ص: 8
هذا الإنسان العاجز هو الذي يشكل خطراً على المجتمع لو ترك على هذا الحال ، ولم تؤخذ مشمكلته بعين الاعتبار ... ذلك لأن مثل هذا الإنسان قد لا يطيق صبراً ليواجه هذا النوع من الحرمان ، فيضطر بالأخير إلى إرتكاب الجرائم ليحصل من وراء ذلك على المال ، ولقمة اللعيش ، ولسنا بحاجة لذكر الكثير من المشاهد التي تمثل الفقر ، والتي تكون السبب في إشاعة الفوضى ، والجريمه من فتى عاطل ، وقد غُلقت في وجهه الأبواب ، أو كبير أقعدته الأيام أو أم فقدت كفيلها بعد أن ترك لها رعيلاً من الصغار.
أو فتاة تحافظ على عفافها ، ولكنها تواجه من لا يرحمها إلا بتقديم أعز ما لديها هديه رخيصه إليه.
وقد تستقبل أرصفة الشوارع صنوفاً ألفوا إليها يفترشونها أذا داهنهم الليل يلقون بين منعطفاتها أجساداً أنهكها التسول تاركين لعيونهم أن يداعبها الكرى وطائف يطوف عليهم يناغيهم بصوت ألفوا نغماته في مثل هذا الوقت من الليل وهو يقول ..
نامي فأن لم تشبعي *** من يقظة فمن المنام
هذا الحشد من المساكين ماذا نقول لهم لو أقدموا على الجريمه فسرق بعضهم وباع كرامته آخر وتطاول ثالث فقتل نفساً محترمة.
عندها نجد أنفسنا تؤمن شاءت أم أبت بالحديث الذي يقول :
« كاد الفقر أن يكون كفراً ».
ولكن سرعان ما تتلاشى هذه الصور إذا ما استجاب الموسرون لنداء القرآن ، والسنة فأدوا ما عليهم من الحقوق إلى الفقراء والمستحقين ، وأقرضوا الله قرضاً حسناً ، وأنفقوا في سبيل الله - وفي هذه الحالة - لا يبقى مجال الجريمة ، بل يعود
ص: 9
الجميع إلى حضيرة الإسلام ، وهم يطبقون تعاليمه ، وبذلك يؤمنون لمجتمعهم السعادة ، والرفاه ، وبعدها يقف الإسلام في وجه من تسول له نفسه أن يرتكب الجريمة لينزل به العقوبات الصارمه لأن الجريمة في هذه الصورة لاتكون وليدة الحاجة ليعذر في بعض الصور من يرتكبها لو خاف على نفسه من الوقوع في التهلكة ، بل هي وليدة النفوس الشريرة الخبيثة ، ولذلك لا ترحم القوانين السماوية ، والوضعية مثل هؤلاء ، بل تلاحقهم لتستأصل مادة الفساد بأقتلاع جذور الجريمة.
وفي الختام : اضرع إلى الله القدير أن يصلح لنا نفوسنا ، وشؤوننا ويرزقنا كرامة الدنيا والآخرة. وهو الموفق
صفر - 1408 النجف الأشرف
عز الدين السيد علي بحر العلوم
ص: 10
من الأمور المهمة التي تبناها الإسلام كأساس للنظام الإجتماعي في هذه الحياة هي نقطة الاعتدال ، والأخذ بالحد الوسط في كل شيء يخص الفرد من أعمال وشؤون ، وقد ساق القرآن الكريم مثالاً لهذه الصورة فقال سبحانه :
( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ) (1).
فلا إسراف ولا تقتير بل أمر وسط بين أمرين ، والآية الكريمة وإن كان موردها الصرف والانفاق ، ولكن آيات القرآن دستور لا يخصص المورد فيها الوارد بل الوارد فيها فقرة من فقرات الدستور الإسلامي تؤخذ تلك الفقرة كحكم أو كقاعدة تعم جميع الموارد وفي جميع العصور إلا أن يدل دليل من آيات أخرى ، أو من السنة الكريمة على الاختصاص وعدم الشمول.
واذاَ فالآية الكريمة تشير إلى أن التوازن نقطة أساس لابد من المحافظة عليها وأن الاخلال بها يضر المجتمع ، ويجر عليه الويلات.
ومن هذا المنطق تنظر الشريعة المقدسة إلى حرية الفرد في التملك والصرف ، والأخذ ، والعطاء.
فهي لا تترك الفرد يتمتع بحرية مطلقة في نطاق التملك ، والحصول على الثروة كيف يشاء ، ومن أي طريق كان ليكون هو المالك الوحيد ، ولا حق فيه لغيره يملك ما يشاء ، ينفق حسب ما يريد من دون قيد أو شرط.
ولكنها في الوقت نفسه لا تحرمه من حقه الطبيعي فتسلب منه الملكية الفردية ، وتجعل ما يحصل عليه ملكاَ لغيره ، وخاضعاّ للسلطة بحيث يكون الفرد عاملاً لا
ص: 11
يملك لنفسه إلا ما يقيم له حياته المعاشية في أبسط أنواعها.
لا هذا ولا ذاك بل حد وسط بين الأمرين.
الإسلام يحترم الفرد ويأخذ بعين الاعتبار ما يحقق له كرامته ولكن في نطاق المجموعة وحدود المجتمع الذي يعيش فيه لأنه كما يلحظ المصلحة الخاصة كذلك يضع في حسابه المصالح العامة ، بل قد تقدم المصالح العامة في بعض الموارد على المصلحة الخاصة لو أقتضت الضرورة لمثل هذا الاجراء ومن ذلك.
1 - لو أسر الكفار بعض المسلمين : وجعلوهم في الصف الأول ، وفي الخط الأمامي من المعركة ليكونوا عقبة في طريق زحف المسلمين ، فإن الشارع المقدس يأمر المسلمين بالتقدم ، ولو أقتضى ذلك قتل هؤلاء المسلمين الأسارى وحينئذ فلهؤلاء الجنة ، ولورثتهم الدية تستحصل من بيت المال.
2 - الاحتكار : وهو حبس السلعة والامتناع عن بيعها لأنتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها.
وهذا العمل حرام من حيث المبدأ ، ويجبر المحتكر على البيع من دون أن يعين له السعر.
نعم إذا كان السعر الذي إختاره مجحفاً بالعامة أجبر على الأقل (1).
ولسنا في صدد تعين ما يختص به هذا الحكم من الأجناس ، والحاجيات ، فهل هو كل ما يحتاج إليه المسلمون من السلع أم أنها مختصة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير ، ويستحب في الباقي ؟ فلذلك مورده الخاص من كتب الفقه.
بل المهم هو بيان أن الاحتكار ، ولو في بعض الحاجيات من موارد تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
ص: 12
3 - حق المارة : ويتمثل ذلك في الأثمار المتدلية في بعض البساتين على الطريق فإن لم يكون مرورها عليها لا بنحو القصد إليها أن يتناول في ذالك الثمر بشروط تتعرض لها مصادر الفقه.
وهناك كثير من هذا الموارد لاحظ الشارع المقدس فيها المصلحة العامة فقدمها على المصلحة الخاصة.
ومن هذا القبيل ما نحن فيه ، وبالنسبة إلى ما يحصل عليه الفرد من الثروة والتصرف فيه فإن الإسلام يبيح له ذلك ليعمل طاقاته في سبيل الإنتاج ، ولكن لا ينافي هذا أن يضع له مقاييس خاصة لابد من رعايتها حفاظاً منه على التوازن وعقبة في طريق التضخم الذي ينشأ من جراء هذه الحرية بدون قيد أو شرط ، ولئلا ينعم بعضهم على حساب الآخرين أو يتخم بعضهم ، ويجوع آخرون.
وفي هذا الصدد يقول الإمام الصادق علیه السلام : « ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير » (1).
ومن هذا العرض نخلص إلى أن الفرد في حياته المعاشيه حر ومقيد.
حر : في التملك والتصرف في قبال الأنظمة والتي تسلبه الحرية ، وتجعله أداة لغيره.
ومقيد : بالنسبة إلى بعض أسباب التملك ، أو بالقيود التي توضع عليه بعد التملك رعاية للمصالح التي تقتضيها طبيعة المعايشة في المجتمع الإسلامي.
وقد نواجه ونحن نقول بهذه الازدواجية من التملك والتصرف المقيدين باشكال يقول فيه بعضهم :
ان جعل المقاييس من قبل الشارع المقدس ضابطاً لحفظ التوازن ينافي ما تقرره
ص: 13
القاعدة المشهورة ، التي يتفق عليها كلهم من أن الناس مسلطون على أموالهم ، إذ من الواضح أن تقييد الحرية المذكورة في التملك والصرف معناه الحد من هذه السلطة التي أقرها الشارع ، التي بها يتمكن الفرد من التصرف بما عليه كيف يشاء !.
والجواب عن ذلك :
ان الإنسان قد يتصور انه عندما يحصل على شيء ، أو يستولي عليه بأحد الطرق المشروعة أنه هو المالك الحقيقي لذلك الشيء ، وليس لأحد أن يتدخل فيما يعود لحرية التصرف فيه ، وهذا لحدٍ ما صحيح وأن القاعدة المشهورة من الناس مسلطون على أموالهم أيضاً معترف بها ، ولكن علينا أن نعرف قبل كل شيء أن هذه السلطة ، وهذه الملكية هما بالنسبة إلى ما يعود إلى الناس فيما بينهم ، وأما بالنسبة إلى الفرد مع خالقه فالقضية تأخذ طابعاً آخر وشكلاً جديداً.
ذلك لأن الملكية الحقيقية إنما هي لله وحده من غير شريك ، وأن السلطة الكبرى له من غير منازع ، وإنما للإنسان من الملكية ما هو محدود له من قبل الله سبحانه.
وعندما يرزق الله أحداً مقداراً من المال فقد يتخيل الإنسان أن ما حصل له كله ملك له. إلا أن ذلك خيال محض وتصور فارغ بل هو يملك المقدار المخصص له لا غير.
وعلى سبيل المثال لو حصل الإنسان على مقدار عشرة دنانير ، وقلنا ان للفقراء اثنين من هذه العشرة حقاً شرعياً فمعنى ذلك أنه من أول الأمر كان قد ملك ثمانية لا أكثر اما ملكه لتمام العشرة فهو ملك صوري ، وإنما الحقيقي هو الثمانية لا غير.
وليس في هذا أي جور على الفرد فإن من أعطاه المال قيده بهذا النحو من العطاء اعطاه مقداراً خاصاَ والزائد ليس له ، وغير مسلط عليه.
ان المال كله هبة من الله ، وهو مال الله حتى بعد حصول العبد عليه ، وفي هذا
ص: 14
الصدد تقول الآية الكريمة : (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) (1).
فهو من مال الله ، ولذ أمر بأعطائه منه ، ولو لم يكن ماله لما أمر باعطائه إذ لا معنى لأن يأمر الله بإعطاء ما ليس له ، بل الحقيقة باقية حتى بعد وصوله إلى الأفراد.
ويقول سبحانه في آية أخرى : (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) (2).
وإذا كانت معاملة الله لعبده على المال معاملة الاستخلاف فهو اذاً أمين على ذلك فلماذا يتضايق الإنسان من الضوابط التي يجعلها المالك الحقيقي على ما إستخلف عليه.
ولماذا نقتصر في الملكية على هذا التقييد بل المال ، ومن وصل إليه ، والأرض والسماوات وما فيها كل ذلك مملوك لله.
(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (3).
فكل شيء في هذا الوجود بسمائه ، وأرضه ، وما فيها ، وما بينهما مملوك له ملكية مطلقة وغير محدودة بحدود ، ولا مقيدة بقيود.
وبعد هذا العرض فلا منافاة بين القول بتسلط الفرد على ماله ، وبين القيود والضوابط التي يجعلها الله على الأموال تملكاً وتصرفاً.
(مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (4).
ص: 15
التكافل الإجتماعي ، عنوان يراد منه التحام الافراد فيما بينهم في اطار من الود والرحمة يشد بعضهم بعضاً ، كما يقول الحديث الشريف : « المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضة بعضاً ».
وللتكافل مظاهر متعددة :
فالجهاد في سبيل الله - ينضم الأفراد بعضهم إلى بعض ليقفوا في بوجه العدوا من التكافل.
والمهندس ، والطبيب ، وكل ذي فن وحرفة يقوم بعمله من التكافل ، وتقديم الخدمات الخاصة ، والعامة من التكافل.
ورعاية اليتيم أيضاً من التكافل.
وافراد الأسرة كل يقوم بواجبه الأسروي من التكافل.
واسداء النصح ، والكلمة الطيبة يقدمها الإنسان إلى غيره من التكافل.
ومد يد العون إلى الفقراء ، والضعفاء من التكافل.
وبتعير شامل القيام بما يعود إلى المجتمع على نطاق الأفراد ، والمجموعة ككل من التكافل.
إن الحياة الإجتماعية ليست بالامكان أن تنتظم بجهود الفرد كفرد بل بجهود الفرد منظماً إلى المجموعة ليصل الجميع إلى هدفهم المنشود.
والتكافل يريده الإسلام ، ويحث عليه لأنه صورة شفافة يعبر عن الرحمة والحنو والعطف والشفقة ، وقد أراد الله ذلك لعباده لأنه سبحانه المنبع الحقيقي للرحمة ، والشفقة والسماحة.
فهو رحيم ، ويحب الرحمة ، ويوصي بالرحمة.
والإنسان هو الصورة المثالية لصنع الله في هذه الأرض الواسعة ، وقد ميزه عن بقية مخلوقاته بالعقل والادراك ، ومنحه من الطاقات الجبارة ما به تظهر عظمته في هذا الكون لذلك أراد الله أن يحذو حذوه لتعبر الصورة عن قدرة المصور ومكانتة ، وقد إختاره ليكون الشاشة الواضحة ليعرض عبرها كل الصفات الخيرة تلك
ص: 16
الصفات التي أراد أن يتصف بها العبد.
ومن هنا نقول إن هذه الحياة بما هي مكان يعيش في رحابها هذا الحشد من البشر لابد لها من نظام تكافي ينظم للأفراد حياتهم ومتطلباتهم ، يظللهم شعورهم بالمسؤولية « فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »(1) ، كما يقول أمير المؤمنين الإمام علي علیه السلام .
وعلى ضوء هذا النظام تزدهر الحياة ، وعلى تطبيقه يشق المجتمع طريقه نحو الرقي والرفعة.
- وكما قلنا - إن التكافل الإجتماعي له مظاهر متنوعة ، ولم يقتصر على مظهر واحد ، بل هو مجموعة صور عديدة قيمة.
ومن بين هذه الصور تتألق صورة الانفاق في سبيل الله ، ومد يد العون إلى الضعفاء والمعوزين ليجد هؤلاء من يحنو عليهم ، ومن ينتشلهم من براثن الفقر ، ويبعد عنهم صوره المرعبة وبذلك تتوازن القوى ، ويتجه كلهم نحو بناء مجتمع مثالي في كل عصر ، ومع كل جيل.
وحديثنا في هذا البحث عن التكافل في الإنفاق لان المال وتوزيعه على شكل يؤمن للغني غناء ، وللفقير حقه هو من القواعد الأساس لعملية التكافل لذلك رتب الإسلام نظاماً للإنفاق لئلا يسرف الإنسان في ذلك ، أو يقتر.
(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ) (2).
وقبل أن نبدأ في البحث عن كيفية هذا النظام ، والحديث عنه نقف لنجيب عما نطالب به من إيضاح حول ما يوجه من الاعتراض عن مشكلة الفقر وابتلاء البعض من الناس بالفقر والعوز مع أن الله سبحانه هو الخالق خلائق ورازقهم هو الذي قدر بينهم معايشهم :
(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) (3).
ص: 17
(نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (1).
( وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ) (2).
وإذا كان الرزق من الله ، وهو الذي يقدر معايش العباد فلماذا لم يمنح الفقير ما يغنيه ليجعل العباد كلهم على حد سواء ، أو لا أقل من أن يكفي الفقير ان لم نقل بالتساوي ؟ وحينئذٍ فيمنحه ما يرفع عنه الاتكال على ما تجود به قريحة الغني وتعود حياته رتيبة تسير على نحو من الكفاف ، وبذلك يستغنى عن قانون فرض الضرائب المالية على الأغنياء الزامياً ، أو تبرعياً ، ولا داعي لهذه الصورة من التكافل بل تبقى للتكافل صوره الأخرى مما يحتاجه لهذه الحياة.
والجواب عن ذلك : إن الله ليس بعاجز عن أن يجعل عباده في مستوى واحد من حيث الغناء والرفاه المالي فقد نوه القرآن الكريم في آيات كثيره من أن الله هو الرازق :
(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ) (3).
(هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (4).
ولكنها المصالح التي تعود إلى البشر ، والتي تقضيها طبيعة الحياة العلمية في واقعها الخارجي هي التي تدعوا لأن يكون هذا التمايز.
ذلك لأن الحاجة أساس العمل والعمل يخلق الانتاج ، وإذا كان الكل في صف واحد فمن يعمل ، وكيف يحصل الانتاج ؟.
وعلى سبيل المثال : فلوا فرضنا أن بلداً كل أفراده أغنياء ، ويتمتعون بثروات مالية فمن منهم يحضر لينزل إلى الحقل ليحرث ويزرع ، ومن منهم يبني ، ومن منهم يحرك الآلة ، ومن منهم يقوم بما تتطلبه هذه الحياة من أعمال ؟.
ص: 18
ان الحاجة هي التي تدعوا العامل أن ينشد إلى رب العمل ، ورب العمل إلى العامل ، وهكذا ، ومن جراء ذلك تؤمن متطلبات الحياة ، وما يحتاج إليه الفرد من طعام وكساء وسكن.
على أن هناك نقطة دقيقة كشف عنها القرآن الكريم ، وأوضح أن الله سبحانه ينزل الارزاق حسب موازين مظبوطة وإنه أعلم بعباده ، وكيف أن بعضا منهم لو أغناه ووسع عليه لكفر.
يقول سبحانه : (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ) (1).
وختام الآية (إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ) يعطينا أن التقدير الذي يقدره الله لعباده نابع عن خبرة ، وبصيرة بشؤون العباد إنه يعلم لو وسع على العباد في الرزق على حسب ما يطلبونه ، ويرغبون فيه لبغوا في الأرض ، والبغي في اللغة ، هو « الظلم والجرم والجناية ، والباغي هو الظالم ، والعاصي على الله » (2).
ولكن ( ينزل بقدر ما يشاء ) ، وعلى قدر صلاحهم ، وما تقتضيه مصالحهم ، وقد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله عن جبرائيل عن الله سبحانه : « إن من عبادي من لايصلحهُ إلى السقم ، ولو صححته لأفسده ، وإن من عبادي من لايصلحهُ إلا الصحة ، ولو سقمته لأفسده ، وأن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ، ولو أفقرته لأفسده ، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ، ولو أغنيته لأفسده ، وذلك إني أدبر عبادي لعلمي بقلوبهم » (3).
وبعد كل هذا فإن الأحاديث الواردة عن النبي صلی الله علیه و آله ، وأهل البيت علیهم السلام تتناول هذه المشكلة. وتدفع الأشكال على نحو الجزاء والأجر للفقير على ما قسمه
ص: 19
الله له من فقره.
فعن النبي صلی الله علیه و آله انه قال :
« يؤتى بالعبد يوم القيامة ، فيعتذر الله إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا ».
فيقول :
« وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك عليّ ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيله أخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن اطعمك فيّ أو كساك فيّ يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك ، والناس يومئذ قد الجمهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك بيده فيأخذ بيده ويدخله الجنة » (1).
وعن أمير المؤمنين علیه السلام :
« إنه قال : لرجل أما تدخل السوق أما ترى الفاكهة تباع ، والشيء مما تشتهيه : فقال : بلى.
قال علیه السلام : أما إن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه حسنة » (2).
بهذا النوع من الأجر والتقدير يقابل الفقير ليجبر الله له ما يعانيه في هذه الدنيا من تبعات الفقر.
وهنيئاً له والله.
يعتذر إليه أو هو شبيه بالمعتذر كما في بعض النسخ ، ويتوالي التكريم من الله سبحانه لعبده الفقير فتعطينا الأحاديث مرة أخرى صوراً متلألئةً تضفي اشعاعاً خاصاً على الفقير يميرة عن بقية الناس.
فقد جاء في بعض الأحاديث ان الله سبحانه أوصى لنبيه اسماعيل قائلاً : « اطلبني عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. فقال : اسماعيل من هم ؟ قال : الفقراء الصادقون » (3).
والفقراء بعد كل هذا صفوة الله من خلقه.
ص: 20
« فعن النبي محمد صلی الله علیه و آله يقول الله تعالى يوم القيامة : أين صفوتي من خلقي ؟ فتقول الملائكة ، ومن هم يا ربنا ؟ فيقول : فقراء المسلمين القانعون بعطائي الراضون بقدري أدخلوهم الجنة فيدخلوهم ويأكلون ويشربون ، والناس في الحساب يترددون » (1).
وفي مورد آخر يقارن الله بين الفقراء والأغنياء فيجعل الكفة تميل لصالح الفقراء ، جاء ذلك عن الإمام الصادق علیه السلام :
« ان الله يقول يحزن عبدي المؤمن ان قترت عليه ، وذلك أقرب له مني ، ويفرح عبدي المؤمن ان وسعت عيله ، وذلك أبعد له مني » (2).
ومرة أخرى نعود لصلب الموضوع في البحث لنتكلم عن الانفاق بقسميه الإلزامي والتبرعي.
ص: 21
ويشتمل على أمرين :
أ - الضرائب المترتبة على الأموال.
ب - الضرائب المترتبة على الأعمال.
1 - الزكاة.
2 - الخمس.
الزكاة في اللغة هي : النماء ، والطهارة ، وزكا الشيء نماء وتكاثر ، وزكت النفس طهرت ، ومنه قوله تعالى :
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (1).
تطهرهم من البخل والسحة وحب المال. وتزكيهم بنماء أموالهم وحسناتهم ، وتهذيب نفوسهم ، وبذلك يرتفعون إلى منازل المخلصين الطيبين (2).
أما الزكاة في المصطلح الشرعي فهي :
« أسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب » (3).
وعندما نعبر عن الزكاة بأنها ضريبة على المال الذي يحصل عليه الإنسان أو لحق يجب قي المال فلا ينافي هذا التعبير انها في الوقت نفسه عبادة مالية يتوخى الشارع من فرضها تنظيم الاقتصاد وترتيب الحياة بشكل متوازن بلا تخمة ولا حرمان بل حد
ص: 22
وسط بين هذين الشبحين المرعبين.
يقول الإمام الصادق علیه السلام :
« إنما وضعت الزكاة اختباراً للأغنياء ومعونة للفقراء ، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقير محتاجاً ، ولاستغنى بما فرض الله له وأن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء... » (1).
وإذا ما أردنا أن نعرف ما للزكاة من أهمية في نظر المشرع رجعنا إلى القران الكريم والسنة لنرى اللآيات ، والأحاديث قد أمرت باخراجها مقترنة بالأمر باقامة الصلاة في أكثر من عشرين آية ، وفي أحاديث عديدة حيث دأبت الآيات تكرر قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)(2).
وفي الحديث الذي بيّن فيه أمير المؤمنين علیه السلام (فدعائم الإسلام وهي خمس دعائم ... أولها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الولاية ... إلخ الحديث)(3) .
فجاء ترتيبها بعد الصلاة مقدمة على الصيام.
وفي حديث آخر عن الإمام الباقر علیه السلام انه قال : « عشر من لقى الله بهن دخل الجنة : شهادة ان لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، والاقرار بما جاء من عند الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ... الخ الحديث» (4).
ولسنا في صدد ما للصلاة من أهمية في نظر المشرع ، وإنها من أهم أركان الإسلام ولكن على نحو العرض السريع نقول :
لقد نوهت الأحاديث بعظمة الصلاة في كثير من الموارد ، وبينت إنها عمود
ص: 23
الدين ، وأنها إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها ، وأنها لا تترك بحال ، وحتى في حال الغرق لابد من الاتيان بها ولو بالايماء بالعينين.
هذا الواجب العبادي ، وبهذا النحو من الأهمية نرى الشارع المقدس قد قرن معه الزكاة.
وبأكثر من هذا فقد دأبت الأحاديث الكريمة تصرح بأن بين أداء الزكاة وإقامة الصلاة نحو إرتباط.
فقد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله قوله : « أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم » (1).
وهل يستعظم الإنسان هذا النوع من الارتباط فكيف ان من صلى ولم يزك أمواله لم تقبل صلاته مع أنه تقبل بحسب الموازين الشرعية ، ويأتي الإيضاح عن الإمام الباقر علیه السلام في حديث له يقول فيه :
« إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن أقام الصلاة ، ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة » (2).
وإذاً : فالارتباط بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أرتباط تنزيلي ، ويفهم من قوله « فكأنه لم يقم الصلاة » بمعنى أن تارك الزكاة صلاته ليست تلك الصلاة التي ينظر إليها الله بنحو من الأهمية ، والأعتبار.
وعلى الصعيد الأجتماعي لو تأملنا هذه المقارنة لرأينا من خلال كل هذه الآيات والأحاديث أن الشارع المقدس يتوخى من الأمر بهذين الواجبين على نحو الارتباط ولو تنزيلاً أن يجعل المكلف إنساناً مهذباً كاملاً.
فبصلاته : ينشد إلى خالقه يسبحه ويحمده ويعترف بالعبودية له ، وبذلك تصفو
ص: 24
نفسه شفافة تنطبع فيها كل سمات الخير والرحمة.
وبزكاته : ينشد الفرد إلى المجتمع ليتحسس بأحاسيس أفراده من الضعفاء والمعوزين فيمد لهم يد المساعدة ويبعد عنهم شبح الفقر وآلام الجوع.
وبهذا الصدد يقول الإمام الرضا علیه السلام :
« إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء ، لأن الله عزوجل كلف أهل الصحة القيام بشؤون أهل الزمانة(1) والبلوى كما قال الله تعالى :
(لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ)(2).
في أموالكم : أخراج الزكاة ، وفي أنفسكم : توطين النفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء الشكر لنعم الله عزوجل ، والطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على المواساة ، وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين ...»(3) .
وقد نقلنا من الحديث هذا القدر لنعرض من خلاله ما يتوخاه الإمام عليه السلام من شد الأغنياء والتحامهم بالفقراء وبيان أن الله سبحانه في الوقت الذي يريد من عبده أن يتقرب إليه وتسمو نفسه فتسبح في الرحاب الأعلى بصلاته كذلك يريد منه أن لا يبعد فينقطع عن المجتمع بل لينزل إلى معترك الحياة ليعمل ويقدم من نتاج عمله إلى من أنهكهم الفقر ، وبذلك يكون قد جنب الفقير ويلات الحرمان وما يجره العوز عليه من إرهاصات قد تخرجه من وضعه الطبيعي فيجرم في حق الأخرين.
ونبقى نحن وجزاء من أقام الصلاة وآتى الزكاة لنهرع إلى القرآن الكريم لنراه يقرر ما جاء في قوله تعالى : (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
ص: 25
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا) (1) .
( أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ) وإذا كان التعبير بالعظيم له أهمية لو جاء على لسان البشر فكيف به وقد جاء على لسان الله عزوجل وهو الرحيم بعباده.
من تجب عليه الزكاة (2) :
تجب الزكاة على الأشخاص التالية صفاتهم :
1 - البالغ.
2 - العاقل.
3 - الحر.
4 - المالك للمال.
5 - التمكن من التصرف.
من غير فرق بين الذكر والأنثى ..
تجب الزكاة في :
1 - الأنعام الثلاثة : وهي الابل والبقر والغنم.
2 - الذهب والفضة المسكوكين.
3 - في الغلات الأربع : هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ص: 26
وتستحب فيما عدا ذلك مما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر.
أما أموال التجارات فقد اختلفوا فيها على قولين :
أحدهما : الوجوب.
ثانيهما : الاستحباب(1).
وقد ذكرتهم الآية الشريفة في قوله تعالى :
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (2).
ثانياً .. الخمس (3)
الخمس حق مالي فرضه الله عز وجل على عباده في موارد مخصوصة فكلفهم بأخراج سهم واحد من كل خمسة أسهم مما يحصلون عليه من تلك الموارد أي ما يساوي 20% من الأصل. الموارد التي يجب فيه الخمس :
يجب الخمس في الموارد التاليه :
1 - غنائم دار الحرب.
2 - المعادن.
ص: 27
3 - الغوص.
4 - الكنز.
5 - أرباح التجارات.
6 - المال الحرام المختلط بالحلال.
7 - أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم.
يقسم الخمس بنص الآية الكريمة ، والأحاديث الوارده عن أهل البيت علیهم السلام إلى ستة أقسام :
يقول سبحانه :
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (1).
وقد أوضحت الآية الكريمة ان هذه الأقسام الستة تنقسم إلى قسمين :
الأول : ويتمثل بما أفادته الآية من قوله تعالى :
(فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) .
الثاني : وهو ما بقي من الأقسام : (الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) .
ويقول فقهاء الإمامية بأن الأقسام الثلاثة الأولى هي بيد النبي صلی الله علیه و آله ، أو الإمام علیه السلام من بعده حسبما أستفيد من الأخبار الواردة في هذا الباب.
وأما الأقسام الثلاثة الثانية فهي لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم اعتماداً على ما ورد في هذا التخصيص من الأخبار التي أفادت بأن الله حرم على بني هاشم الصدقة فأبدلهم بالخمس ، وقد تعرضت مصادر الحديث للإمامية فذكرت بهذا الخصوص اخباراً كثيرة جاء فيها ما ألمحنا إليه من السبب في تخصيص بني
ص: 28
هاشم ، ومن هم بنو هاشم ، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع على نحو من التفصيل راجع كتاب وسائل الشيعة وغيره من كتب الحديث أبواب الخمس.
هذا الحقل المالي عندما يخصص النصف منه إلى الإمام ، والنصف الثاني إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم إنما هو صورة من صور التكافل الإجتماعي ، والذي يريده الإسلام ، ويحرص على تطبيقه حيث يجعل من الغني والفقير مجموعة واحدة يتحسس البغض منها بما يحيط بالآخر من العوز والحاجة.
فالفقير يشعر بهذا العطف من الغني ، ولا بد له يوماً ما من أن يقدر له هذا العواطف ليقف إلى جانبه فيما يبتلى به من القضايا التي يحتاج فيها إلى ما يساعده فيها.
وبذلك يكون المجتمع يداً واحدة بغض النظر عن الأفراد ، والقوميات ، وما يميز به الأفراد من فوارق عريقة ، ومذهبية.
وهذه الضرائب يجمعها عنوان « الكفارات » ، وهي عقوبات دنيوية يقصد من ورائها تخفيف ما على الإنسان من العقوبات الأخروية نتيخة مخالفة يقوم المكلف بها بترك عمل مطلوب منه ، أو بالأقدام على عمل ممنوع عنه ، وهي على أنواع :
1 - كفارة القتل : فإذا قتل الإنسان مؤمناً عمداً ظلماً ففي هذه الصورة فرض الشارع المقدس عليه كفارة وهي : (عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً).
وأما لو كان القتل خطأ فكفارته (عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز إطعم ستين مسكيناً).
2 - كفارة الأفطار في شهر رمضان : فمن أفطر يوماً من شهر رمضان فكفارته (عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً).
3 - من أفطر يوماً : من قضاء شهر رمضان بعد زوال الشمس فكفارته (اطعام
ص: 29
عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام).
4 - فدية الأفطار عن مرض : وهذه الفدية تتحقق على من أفطر في شهر رمضان عاجزاً عن الصوم لمرض نزل به ، واستمر به المرض إلى رمضان قابل حيث يعجز عن القضاء أيضاً فيفدي عن كل يوم باطعام مسكين واحد.
5 - كفارة الظهار : وعملية الظهار هو أن الرجل يترك وطء زوجته معتبراً أياها كأمه فيقول له « أنتي علي كظهر أمي » وهي عبارة يراد منها أن المرأه حرام عليه كحرمة أمه عليه ، فلو أراد الرجوع إليها كفر عن هذه العملية بعتق رقبة فأن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز اطعم ستين مسكيناً.
6 - كفارة الايلاء : والإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة وحينئذ فيكفر من يريد الرجوع بعتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
7 - كفارة اليمين : وذلك حيث يحلف الإنسان ان يفعل شيئاً ، أو يتركه ، ثم يعدل عن ذلك ، وفي هذه السورة تكون كفارته عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
8 - كفارة النذر : وهو أن ينذر لله تعالى نذراً ويكون عليه الإيفاء إذا تحقق فإذا أخل بذلك فكفارته عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
9 - كفارة العهد : والعهد هو أن يقول « عاهدت الله على كذا أو عليَّ عهد الله أنه متى حصل الشيء الفلاني فعليّ الشيء الفلاني » ، فإن أخل فعليه الكفارة وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً.
10 - كفارة المخالفة في الاحرام : فإذا أخل الحاج بشرط من شروط الحج في الإحرام يكفر عن ذلك بذبيحة على تفصيل مذكور في بحوث الحج من الفقه.
إذا استعرضنا هذه الكفارات رأيناها تحتوي على :
ص: 30
1 - عتق الرقبة.
2 - الصيام.
3 - الاطعام للمساكين.
هذه الأمور الثلاثة هي موضوع الكفارة المفروضة على المكلفين عند اخلالهم بشيء مما ذكرناه ، أو قيامهم بأمور لايريد الإسلام تحققها كالقتل والظهار والايلاء.
ومن خلالها تظهر لنا فكرة التكافل والتعاون جلية واضحة ولنستعرض كلاً منها :
1 - عتق رقبة : والمراد به تحرير العبد من الاسترقاق ، وهذه عملية انسانية تكافلية يشم فيها انسان نسمات الحرية بعد أن حكمت عليه الظروف أن يكون مملوكاً لآخرين.
ان العبد ليشعر بالجميل عليه وهو يرى نفسه وقد القى الطوق الذي كان يقيده ، ولا بد له ان يكافئ ذلك الشخص الذي كان السبب في خلاصه من هذه العبودية ، وبذلك تلتحم القوى بين المعتِق والمعتَق ، ويتحسس كل منهما بما تحل بالآخر من أزمات.
2 - الصوم : ويصوم الشخص نتيجة ابتلائه بهذه الكفارة ليكون رادعاً له عن الرجوع لمثل هذه المخالفة ، وفي الوقت نفسه ليتحسس بالآم الفقراء والضعغاء ، وليشعر بلوعة الحرمان ، وما يسببه الجوع من ارهاصات قد تخرجه عن الوضع الطبيعي الذي اعتاد عليه ، وليعلم ان الفقير أيضاً بشر ومن حقه أن يتمتع بهذه الحياة ، ومن ثم ليملأ معدته بالطعام ، وهذا التحسس كاف لأن يخلق منه إنساناً تكافلياً قد أحسنت تأديبه الكفارة.
3 - الاطعام : قد لا يوطن الإنسان نفسه على أن ينفق على الفقير تبرعاً وبدون سبب ، ولكن الشارع بهذا الأجراء يجبره على أن يتفقد الفقير ويقدم له طعاماً ليرفع عنه غائلة
ص: 31
الجوع ويشبعه جزاء ما صنعه من مخالفة ، وبذلك يكون الإسلام قد هيّأ للضعيف مورداً من موارد العيش يقدمه الغني له من غير من ، ولا جميل.
وعلى أي حال ان الإسلام بتشريعه لهذا النوع من العقوبات لا يريد أن يتشفى من المكلف بإيذائه ، بل يريد أن يخفف من عقابه في الآخرة ويصوغ منه إنساناً مهذباً في دنياه يحمل قلباً ملؤه الرحمة ونفساً عالية شفافة تكمن بين جوانبها كل سمات الخير والصلاح.
لقد حث القرآن الكريم في آيات عديدة ، وموارد كثيرة على البذل والانفاق إلى الطبقات الظعيفة لانعاشهم وإبعاد شبح الفقر عنهم.
كما وقد تعددت الإساليب التي عرض بها هذه الفكرة ، والطرق التي سلكها لتحبيبها إلى النفوس. قبل أن نبدأ :
ولنا وقفة مع القارئ قبل أن نبدأ بعرض تلك الطرق لنوفق بين هذا النوع من الحث على الإنفاق ، وبين ما عرف عن الإسلام من أنه دين عمل وجد ونشاط.
فيقال : إن هذا الحث من الشارع المقدس على البذل والإنفاق قد يكون سبباً لانتشار البطالة وتشجيعاً على عدم العمل ، وما على الفرد إلا أن يجلس في بيته ويتكل على عطايا المحسنين ، أو يتكفف ويتسول ويقطع الشوارع يمد يداً لهذا وأخرى لذلك يتمتم بكلمات يستدر بها عطف المحسنين كما نشاهده في كثير من الطرقات.
وهذا النوع من الحث على الانفاق الموجب لهذا النوع من البطالة ينافي ما عليه الإسلام ، وما هو معروف من مبادئه من انه ينكر البطالة ويحث عل العمل وعدم الاتكال على الآخرين.
ص: 32
ويقول النبي صلی الله علیه و آله : « ملعون من القى كلّه على الناس » (1).
ويقول الإمام علي بن أبي طالب علیه السلام :
« لنق-ل الصخر من قلل الجبال *** أعز الي من م-ن-ن ال-رجال
يقول الناس لي في الكسب عار *** فقلت العار في ذْل السؤال »(2)
بهذا الأسلوب يواجه الإسلام الأفراد فهو دين العزة والرفعة ، وهو دين الجد والعمل ، ولا يريد للمجتمع أن يعيش أفراده يتسكعون ويتكففون.
فلماذا اذاً يعودهم على الاتكال على غيرهم ؟.
للإجابة على ذلك نقول :
إن الإسلام بتشريعه الانفاق بنوعيه الالزامي والتبرعي لم يرد للأفراد أن يتكلوا على غيرهم في مجال العيش والعمل بل على العكس نراه يحارب بشدة الاتكالية ، والاعتماد على أيديِ الآخرين.
بل الإسلام يكره للفرد أن يجلس في داره وله طاقة على العمل ، ويطلب الرزق من الله فكيف بالطلب من انسان مثله.
يقول الإمام الصادق علیه السلام : « أربعة لا تستجاب لهم دعوة رجل جالس في بيته يقول : اللهم أرزقني فيقال له : ألم آمرك بالطلب ؟ » (3).
وفي حديث آخر عنه علیه السلام فيمن ترد دعوته : « ورجل جلس في بيته وقال : يا رب ارزقني » (4).
ص: 33
وهناك احاديث أخرى جاءت بهذا المضمون ان الله الذي قال في أكثر من آية (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ، ووعد بالاستجابة بمجرد دعاء عبده ليكره على لسان هذه الأخبار وغيرها أن يدعوا العبد بالرزق ، وهو جالس لا يبدي أي نشاط وفعالية بالاسباب التي توجب الرزق.
واذاً فالإسلام عندما شرع بنوعية الإلزامي والتبرعي لم يشرعه لمثل هؤلاء المتسولين بل حاربهم ، واظهر غضبه عليهم.
فعن النبي صلی الله علیه و آله إنه قال :
« ثلاثة يبغضهم الله - الشيخ الزاني ، والغني الظلوم ، والفقير المحتال» (1).
إنما شرع الإنفاق للفقير الذي لا يملك قوت سنته ، وقد اضطره الفقر لأن يجلس في داره.
وقد تضمنت آية الزكاة مصرف الزكاة فحصرت الاصناف الذين يستحقونها في ثمانية اثنان منهم الفقراء ، والمساكين ، وستة أصناف لم يؤخذ الفقر صفة لهم بل لمصالح خاصة استحقوها :
يقول سبحانه :
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (2).
وأما مصرف بقية موارد الانفاق الإلزامي من كفارات ، والإنفاق التبرعي فكلفه للفقراء.
والفقراء في المصطلح الشرعي هم الذين يستحقون هذا النوع من المساعدة كلهم اخذ فيهم أن لا يملكوا قوت سنتهم ، أو كان ما عنده من المال لا يكفيه لقوت سنته أما من كان مالكاً لقوت سنته وأخذ منها فهو محتال وسارق لقوت غيره.
ص: 34
ولا يعطى من الصدقات ، وإذا اعطي من الصدقات فمن التبرعية لا الإلزامية وله عند الله حسابه لو عوّد نفسه على التكفف والتسول والأخذ من الصدقات التبرعية ، وبه طاقة على العمل.
وكما قلنا إن الأساليب التي اتخذها القرآن الكريم لحث الفرد على هذه العملية الإنسانية كثيرة وبالامكان بيان ابرز صورها وهي :
1 - الترغيب والتشويق إلى الإنفاق.
2 - التنأيب على عدم الإنفاق.
3 - الترهيب والتخويف على عدم الإنفاق.
ولم يقتصر هذا النوع من التشويق على صورة واحدة بل سلك القرآن في هذا المجال مسالك عديدة وصور لتحبيب الإنفاق صوراً مختلفة :
لقد نوخت الآيات التي تعرضت إلى الإنفاق والتشويق له أن تطمئن المنفق بأن عمله لم يذهب سدى ، ولم يقتصر فيه على كونه عملية تكافلية إنسانية لا ينال الباذل من ورائها من الله شيئاً ، بل على العكس سيجد المنفق أن الله هو الذي يتعهد له بالجزاء على عمله في الدنيا وفي الآخرة.
أما بالنسبة إلى الجزاء وبيان ما يحصله الباذل ازاء هذا العمل فإن الآيات الكريمة تتناول الموضوع على نحوين :
ص: 35
الأول : وقد تعرضت إلى بيان أن المنفق سيجازيه الله على عمله ويوفيه حقه أما ما هو الحزاء ونوعيته فإنها لم تتعرض لذلك ، بل أوكلته إلى النحو الثاني الذي شرح نوعية الجزاء وما يناله المنفق في الدنيا والآخرة.
يقول تعالى : (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) (1).
وفي آية أخرى قال سبحانه : (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) (2).
ويظهر لنا من مجموع الآيتين أنهما تعرضتا لأمرين :
الأول : اخبار المنفق واعلامه بأن ما ينفقه يوقى إليه ، وكلمة ( وفى ) في اللغة تحمل معنيين :
أحدهما : انه يؤدي الحق تاماً.
ثانيهما : انه يؤدي بأكثر.
وقوله سبحانه : (يُوَفَّ إِلَيْكُمْ) تشتمل بإطلاقها المعنيين أي يعطى جزاءه تاماً بل بأكثر مما يتصوره ويستحقه والمنفق.
الثاني : تطمين المنفق بأنه لا يظلم إذا أقدم على هذه العملية الإنسانية وهذا تأكيد منه سبحانه لعبده وكفى بالله ضامناً ومتعهداً في الدارين ويستفاد ذلك من تكرار الآية الكريمة وبنفس التعبير في الأخبار بالوفاء ، وعدم الظلم وحاشا له وهو الغفور الرحيم أن يظلم عبداً أنفق لوجهه ، وبذل تقرباً إليه.
هذا النوع من الإطمئنان للمنفق بأنه لا يظلم بل يؤدى إليه حقه كاملاً بل بأكثر.
ص: 36
وفي آية أخرى نرى التطمين من الله عز وجل يكون على شكل آخر فيه نوع من الحساب الدقيق مع المنفقين.
(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (1).
ولم يتعرض سبحانه لنوعية الجزاء من الأجر بل أخفاه ليواجههم به يوم القيامة فتزيد بذلك فرحتهم.
(وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) من فقرٍ ، أو ملامة لأن الله عز وجل هو الذي يضمن لهم ، ثم ممن الخوف ؟
من اعتراض المعترضين ؟ ، وقد جاء في الحديث ( صانع وجهاً يكفيفك الوجوه )(2) ، أم من الفقر ، ونفاد المال ؟ وقد صرحت الآيات العديدة بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم بين الناس معايشهم كما ذكرنا ذلك في الآيات السابقة.
(وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) .
وقد ورد في تفسير هذه الآية أنها نزلت في الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علیه السلام : « كانت عنده أربع دراهم فانفق بالليل درهماً ، وفي النهار درهماً وسراً درهماً وعلانيةً درهماً » (3).
وتتفاوت النفوس في الإيمان والثبات فلربما خشي البعض من العطاء فكان في نفسه مثل ما يلقاه المتردد في الاقدام على الشيء.
لذلك نرى القرآن الكريم يحاسب هؤلاء ويدفع بهم إلى الإقدام على الانفاق وعدم التوقف فيقول سبحانه :
(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (4).
ص: 37
ومع الآية الكريمة فإنها تضمنت مقاطع ثلاثة :
1 - قوله : (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ) .
2 - قوله : (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) .
3 - قوله : (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) .
أولاً : (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ) .
ولا بد للعبد أن يعلم أن الرازق هو الله وأن بيده جميع المقاييس والضوابط فالبسط منه والتقتير منه أيضاً وفي كلتا الحالتين تتدخل المصالح لتأخذ مجراها في هاتين العمليتين ، وليس في البين أي حيف وميل بل رحمة وعطف على الغني بغناه ، وعلى الفقير بفقره فكلهم عبيده وعباده وحاشا أن يرفع البعض على اكتاف الآخرين.
أما ما هي المصالح ؟.
فإن علمها عند الله وليس الخفاء فيها يوجب القول بعدم وجودها.
وفي الحديث عن النبي صلی الله علیه و آله إن الله سبحانه يقول : ( عبدي أطعني بما أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك )(1).
ثانياً : (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) .
فعن جابر عن النبي صلی الله علیه و آله قوله : « كل معروف صدقة ، وکلما أنفق المؤمن من نفقة علی نفسه وعياله وأهله کتب له بها صدقة، وما وقى به الرجل عرضه فهو صدقة ، ... وما انفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلفها ضماناً » (2).
ص: 38
ثالثاً : (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) .
أما أنه خير الرازقين فلأن عطاءه يتميز عن عطاء البشر.
عطاؤه يأتي بلا منة.
وعطاء البشر مقرون بمنة.
وعطاؤه من دون تحديد نابع عن ذاته المقدسة الرحيمة الودودة التي هي على العبد كالأم الرؤوم بل وأكثر من ذلك ، وعطاء البشر محدود.
وكذب من قال انه محدود العطاء :
(بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ) (1).
وقد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله : « ان يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سخاء بالليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه » (2).
وقد جاء الوعد بالجزاء فقط في آيات أخرى فقد قال سبحانه :
(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (3).
(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ) (4).
(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (5).
وقد فسر قوله « عليم » أو « يعلمه » بالجزاء لأنه عالم فدل ذكر العلم على تحقيق الجزاء.
وفي تفسير آخر للآيات الكريمة أن معنى عليم أو يعلمه في هذه الآيات أي يجازيكم به قل أو كثر لأنه عليم لا يخفى عليه شيء من كل ما فعلتموه وقدمتموه لوجهه ولمرضاته عز وجل.
ص: 39
يختلف لسان الآيات بالنسبة لبيان نوعية الجزاء فهي
تارة : تذكر الجزاء ولا ذكر فيه للجنة.
وأخرى : تذكر الجنة وتبشر المنفق بأنها جزاؤه.
وما ذكر فيه الجنة أيضاً جاء على قسمين :
فمرة : نرى الآية تقتصر على ذكر الجنة جزاء.
وثانية : تحبب إلى المنفق عمله فتذكر الجنة وما فيها من مظاهر تشتاق لها النفس كالانهار والاشجار وما شاكل.
ومن الاجمال إلى التفصيل :
يقول سبحانه :
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) (1).
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ) إنما أداة حصر تفيد أن ما بعدها هم المؤمنون هؤلاء الذين عددت الآية الكريمة صفاتهم وهم الذين جمعوا هذه الصفات.
وكانت صفة الانفاق من جملة مميزات المؤمنين وصفاتهم التي بها نالوا هذا التأكيد من الله سبحانه بقوله :
( أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ).
أما ما أعد لهم من جزاء فهو :
( دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) وهي الحسنات التي استحقوا بها تلك المراتب العالية.
( وَمَغْفِرَةٌ ) لذنوبهم من غير حساب على ما فعلوه في هذه الدنيا من مخالفات.
ص: 40
( وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) : وهو رزق لا يصيبه ضرر ولا يخاف من نقصانه لأنه من الله جلت عظمته ، وما كان من الله ينمو وتكون فيه البركة فهو رزق طيب ومن كريم.
وفي آية كريمة أخرى يقول عز وجل :
( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) (1).
( وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ ) .
هؤلاء من جملة من أعد الله لهم المغفرة والأجر العظيم جزاء على هذه الصفة وهذا الشعور التعاطفي بالنحو على الضعيف.
وأما الأيات التي ذكرت الجنة جزاء للمنفق فمنها قوله تعالى :
( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ) (2).
يقف الإنسان عند هذه الآيات وهو يرتلها بخشوع ليلحظ من خلالها إنها فرقت بين صنفين من الناس كافر ، ومؤمن ، وقد وصفت الكافر أنه ( أعمى ) لا يتذكر ولا ينفع معه شيء.
أما المؤمن ، وهو من يتذكر فأنه ينظر بعين البصيرة ، وقد شرعت ببيان أوصاف
ص: 41
هؤلاء المؤمنين ، ومن جملة صفاتهم أنهم الذين ينفقون مما رزقناهم سراً وعلانيةً.
في السر : فإنما هي لرعاية الفقير وحفظ كرامته لئلا يظهر عليه ذل السؤال.
ويحدثنا التاريخ عن أئمة أهل البيت علیهم السلام إنهم كانوا إذا أرادوا العطاء أعطوا من وراء ستار حفاظاً منهم على عزة السائل وكرامته ، وتنزيهاً للنفس لئلا يأخذ العجب والزهو فتمن على السائل بهذا العطاء فيذهب الأجر.
أما في العلانية : فإنما هو لتشجيع الأخرين على التسابق على الخير والاحسان أو لدفع التهمة عن النفس لئلا يرمى المنفق بالبخل والامتناع عن هذا النوع من التعاطف الإنساني.
أما جزاؤهم : فهو العاقبة الحسنة ، وأن لهم الجنة جزاء قيامهم بهذه الأعمال وتفقدهم لهؤلاء الضعفاء في جميع الحالات سراً وعلانيةً.
وفي آيات أخرى نرى القرآن لا يقتصر على ذكر الجنة فقط كجزاء للمنفق بل يتطرق لبيان ما فيها وما هي ليكون ذلك مشوقاً للمنفق في أن يقوم بهذه الأعمال الخيرة لينال جزاءه في الآخرة.
قال تعالى :
( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (1).
وقال جلت عظمته :
( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ
ص: 42
وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ) (1).
وقد تضمنت الآيات نحوين من الجزاء :
الأول : جزاء حسي.
الثاني : جزاء روحي.
أما الجزاء الحسي : فيتمثل بقوله تعالى في الآية الأولى :
(وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ) .
وفي الآية الثانية فيتمثل بقوله تعالى :
(جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ) .
وتأتي هذه الصفات أو المشوقات للجنة من كونها بهذا الحجم الواسع عرضاً فكيف بالطول لأن العرض غالباً يكون أقل من الطول ، ومن أن فيها الأشجار ، ومن تحت تلك الأشجار الأنهار الجارية وفيها أزواج ، وتلك الأزواج مطهرة من دم الحيض والنفاس ، ومن كل الأقذار والقبائح وبقية الصفات الذميمة.
تأتي كل هذه الصفات مطابقة لما تشتهيه النفس ، وما اعتادت على تذوقه في الدنيا من مناظر الأشجار والأنهار والنساء وأن ذلك غير زائل بل هو باقٍ وكل هذه الأمور محببة للنفس وقد استحقها المنفق جزاء تعاطفه وإنفاقه في سبيل الله ونيل مرضاته جلت عظمته.
أما الجزاء الروحي : فيتمثل بقوله تعالى في الآية الأولى :
(وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) . (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ) .
رضا الله ومحبته له والتفاته وعطفه كل هذه غاية يتوخاها الإنسان يبذل بازائها كل غالٍ ونفيس ، وما أسعد الإنسان وهو يرى نفسه محبوباً لله سبحانه راضياً عنه.
على أن في الأخبار بالرضا والمحبة في آيتين تدرجاً ظاهراً وواضحاً فإن المحبة
ص: 43
أمر أعمق من مجرد الرضا وواقع في النفس من ذلك.
وصحيح ان الإنسان يسعى جاهداً ويقوم بكل عبادة ليحصل على رضا الله ، ولكن محبة الله له هي معنى له تأثيره الخاص في النفس.
ان عباد الله المؤمنين يشعرون بهذه اللذة وهذه الراحة النفسية عندما يجد الفرد منهم أنه مورد عناية الله في توجهه إليه.
ويتحول القرآن الكريم إلى إعطاء صورة أخرى من صور التشويق للانفاق والبذل والعطاء فنراه يرفع من مكانة هؤلاء المحسنين ، ويجعلهم بمصاف النماذج الرفيعة من الذين اختارهم وهداهم إلى الطريق المستقيم.
ففي آية يعدّهم من أفراد المتقين ، وفي أخرى من المؤمنين ، وفي ثالثة يقرنهم بمقيم الصلاة ، والمواظبين عليها ، وهو تعبير يحمل بين جنباته بأن هؤلاء من المطيعين لله والمواظبين على امتثال أوامره يقول سبحانه عز وجل :
(ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (1).
ومن خلال هذه الآية نلمح صفة الإنفاق وما لها من الأهمية بحيث كانت إحدى الركائز الثلاثة التي توجب إطلاق صفة المتقي على الفرد.
فمن هم المتقون ؟.
ويأتينا الجواب عبر الآية الكريمة بأنهم :
ص: 44
(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) .
(يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) :
يؤمنون بما جاء من عند الله من أحكامه وتشريعاته وما يخبر به من المشاهد الآتية من القيامة والحساب والكتاب والجنة والنار وما يتعلق بذلك من مغيبات يؤمنون بها ، ولا يطلبون لمثل هذا الايمان مدركاً يرجع إلى الحس والنظر والمشاهدة بل تكفيهم هذه الثقة بالله وبما يعود له.
(وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ) :
فمنهم في مقام اداء فرائضهم مواظبون ولا يتأخرون ويتوجهون بعملهم إلى الله يطلبون رضاه ، ولا يتجهون إلى غيره ، يعبدونه ولا يشركون معه أحداً ، وأداء الصلاة هو مثال الخضوع والعبودية بجميع الأفعال ، والأقوال. يقف الفرد في صلاته خاشعاً بين يدي الله ويركع ويسجد له ، ويضع أهم عضو في البدن وهو الجبهة على الأرض ليكون ذلك دليلاً على منتهى الإطاعة والخضوع ، ويرتل القرآن ليمجده ويحمده ويسبحه ويهلله فهي إذاً مجموعة أفعال وأقوال يرمز إلى الاذعان لعظمته ، والخضوع لقدرته وبذلك تشكل عبادة فريدة من نوعها لا تشبهها بقية العبادات.
(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) :
كل ذلك من الجوانب الروحية ، وأما من الجوانب المالية ، فإن المال لا يقف في طريق وصولهم إلى الهدف الذي يقصدونه من الاتصال بالله فهم ينفقون مما رزقناهم غير آبهين به ولا يخافون لومة لائم في السر والعلن ، وفي الليل والنهار كما حدّث القرآن الكريم في آيات أخرى مماثلة.
هؤلاء هم المنفقون الذين كات الإنفاق من جماة مميزاتهم ، وقد مدحهم الله جلت قدرته بقوله :
ص: 45
(أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (1).
(هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ) :
بلى : هدى وبصيرة فلا يضلون ولا يعمهون في كل ما يعود إلى دينهم ودنياهم. (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) :
بكل شيء مفلحون في الدينا بما ينالهم من عزٍ ورفعة لأنهم خرجوا من ذل معصية الله إلى عز طاعته تماماً كما يقول الإمام أمير المؤمنين علیه السلام :
« إذا أردت عز بلا عشيرة وهيبةً بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته » (2).
ومفلحون في الآخرة التي وعدهم بها كما جاء ذلك في آيات عديدة من كتابه الكريم.
ولم يقتصر الكتاب على هذه الآية في عد الانفاق من جملة صفات المتقين بل درج مع الذين ينفقون من المتقين حيث قال سبحانه :
( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (3).
ومن خلال هذه الآية نرى الأهمية للإنفاق تبرز بتقديم المنفقين على غيرهم من الأصناف الذين ذكرتهم الآية والذين أعدت لهم الجنة من الكاظمين والعافين.
هؤلاء المنفقون الذين لا يفترون عن القيام بواجبهم الإجتماعي في حالتي اليسر والعسر في السراء والضراء يطلبون بذلك وجه الله والتقرب إلى ساحته المقدسة.
وعندما نراجع الآية الكريمة في قوله تعالى :
ص: 46
( الم * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ * هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (1).
نرى نفس الموضوع تكرره الآية هنا ، ولكن في الآية السابقة قالت عن المنفق بأنه من المتقين ، وهنا من المحسنين.
وفي الآية السابقة الانفاق بكل ما ينفق وهنا عن الانفاق بالزكاة ، فالنتيجة لا تختلف كثيراً ، والصورة هي الصورة نفسها إنفاق من العبد ، وتشويق من الله ، ومدح له بنفس ما مدح المتقي سابقاً.
والحديث في الآيتين عن المتقين والمحسنين ، ومن جملة صفاتهم الإنفاق وأداء ما عليهم من الواجب الإجتماعي المتمثل في الإنفاق التبرعي ، أو الإلزامي ، وقد قال عنهم في نهاية المطاف بنفس ما مدح به المتقين في الآية السابقة.
( أولئكَ على هدىً من ربّهم وأولئكَ هُمُ المفلحونَ ) (2).
وفي وصف جديد في آية كريمة أخرى يصفهم الله بأنهم من المخبتين.
( وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) (3).
( والمخبتون ) هم المتواضعون لله المطمئنون إليه.
وعندما شرعت الآية بتعدادهم قالت عنهم : ( الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) .
انها النفوس المطمئنة التي إذا ذكر الله ، - وذكر الله هنا التخويف من عقابه وقدرته وسطوته - وجلت قلوبهم أي دخلها الخوف ولكنه خوف مشوب برجاء عطفه ورحمته، ولا يأس معه من روح الله لأنه :
ص: 47
(لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) (1)، (وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ) :
من البلايا والمصائب ولكنهم صابرون ليجتازوا عقبة الامتحان فتصفى بذلك نفوسهم وتعرف بهذا التحمل قدراتهم وطاقاتهم الروحية في اجتياز هذه العقبات الامتحانية ، وهم في الوقت نفسه ، تقول عنهم الفقرة الآتية من الآية :
(وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ) :
لا يغفلون عن أداء هذا الواجب العبادي المهم رغم ما أصابهم من بلاء ، وما ابتلوا به من محن لأن صبرهم على ذلك أيضاً من العبادة لأنه تحمل لوجه الله وتقرب بذلك إليه تماماً كما يؤدون واجباتهم العبادية الأخرى.
(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) :
ينفقون رغم ما تزل بهم من البلاء ورغم ثباتهم في وجه الأعاصير ينفقون مما رزقهم الله.
ويهيب الله بالمنفقين في آية أخرى فيقول عنهم :
( إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (2).
هؤلاء هم المؤمنون حقاً ومن هم ؟
وتبدأ الآية الكريمة بذكر أوصافهم أنهم :
(الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) .
ص: 48
هؤلاء هم الذين إذا تليت عليهم آيات الله خروا سجداً ، ولا يخفى ما في التعبير بقوله : ( خرّوا ) من لطف وأدب واحترام وخضوع لله شكراً على هدايته لهم بمعرفته وبما أنعم عليهم من نعمة يسبّحونه ويحمدونه على ذلك ، وفي الوقت نفسه يقومون بكل ذلك.
(وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) :
عن عبادته ولا يرون لأنفسهم علواً بإزائه ، ولا يتحرجون من السجود له بتعفير جباههم.
وبتعفير جباههم سجوداً على الأرض سمة تدل على منتهى الخضوع والذلة لو كانت من انسان لأنسان ، ولكنها حيث تكون لله تعطي منتها الرفعة والسمو لأنه سجود لله وخضوع لسلطانه ، ومن أكبر من الله عز وجل ، ومن اعظم منه جلت قدرته.
(تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) :
والتعبير بالتجافي فيه تصوير دقيق لحالة أولئك المؤمنين ، وهم يتركون المخادع مع شدة تعلقهم بالنوم ، وما فيه من لذة وراحة ليقفوا خاشعين بين يدي الله يسبحونه ويقدسونه.
وقد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله : أنه ذكر قيام الليل ففاضت عيناه حتى تحادرت دموعه فقال : (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) .
(يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا) :
يتركون المخادع ويشرعون في مناجاتهم وصلواتهم وهم في حالة مزيجة بين الخوف والطمع.
الخوف : من عذاب الله وعقابه.
والطمع : برحمته وعفوه.
ص: 49
وهؤلاء المؤمنون لا يقتصرون على واجباتهم العبادية إزاء الخالق سبحانه ، بل هم - في الوقت نفسه - يلتفتون إلى واجباتهم الإجتماعية إضافة إلى الواجب الروحية.
ففي الوقت الذي تراهم يحنون إلى الليل وإلى هدوئه الشامل الذي يخيم على المخادع نراهم يؤدون ما عليهم أزاء هؤلاء المعوزين لينفقوا بما فرضه عليهم الواجب الإجتماعي وقد أخبرت عنهم الآية في قوله سبحانه :
(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) :
الصلاة عبادة روحية والإنفاق عبادة إجتماعية وكلا هذين عبادة ، وهل يتركهم الله وهم يتقربون إليه ويتشوقون للقائه وللوقوف بين يديه ؟.
وتتولى الآية نفسها الجواب على ذلك فيقول سبحانه :
(فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (1).
وصحيح أنهم لا يعلمون ما أخفي لهم فالإنسان في تكفيره محدود مهما ذهب به الأمل بعيدا ، ولكن رحمة الله واسعة ، وليبق الجزاء لهم مذخوراً لا يعلم به أحد إلى يوم يلقونه ، ولتقر به أعينهم يوم الجزاء.
(قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ) (2).
وقد تعرضنا لهذه الآية في جانب من جوانبها ، وهو ما تعرضت له من بيان الجزاء للمنفقين وبقي علينا أن نرى ما تعرضت له من الجانب الآخر ، وهو الاشادة بالمنفقين
ص: 50
والأخذ بيدهم إلى الدرجة الرفيعة التي ينالها عباد الله المتقون تقول الآية الكريمة :
( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ - إلى قوله - الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ) .
هؤلاء المؤمنون الذين يتمتعون بجنات ربهم وهم الذين يخشونه ويتوجهون إليه بقلوب مفعمة بالإيمان وبألسنة رطبة بذكر الله يرددون ويلهجون متضرعين يقولون : ( رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) .
وهؤلاء هم وقد وصفتهم الآية :
ب (الصَّابِرِينَ) :
على البلاء يمتحنهم الله في هذه الدنيا لتهذيب نفوسهم وصقلها ليكونوا قدوة لغيرهم ومثالاً للإيمان الراسخ والعقيدة الثابتة.
(وَالصَّادِقِينَ) :
لأنهم عرفوا أن الكذب منقصة للنفس وخيانة في حق الآخرين فتركوه.
(وَالْقَانِتِينَ) :
وهم المطيعون لربهم تعلقوا به واخلصوا له العبودية فكانوا قانتين.
(وَالْمُنْفِقِينَ) :
مما آتاهم الله ورزقهم أداءاً لحقه وشكراً على ما أنعم عليهم ورعاية الحق هؤلاء المحرومين.
(وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ) :
وهو الوقت الذي يخلو به الحبيب لحبيبه يقومون بين يدي الله إذا جنهم الليل متجهين بقلوب مملوءة بالإيمان يستغفرونه ، ويسبحونه.
ص: 51
يقول : في وصفهم أمير المؤمنين علیه السلام :
« أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاً يُحزِنُونَ بِهِ أنفسهم ويستثيرون بِهِ دواء دائهم فأذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وظنوا أنها نصب أعينهم ، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامعهم مع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله فكاك رقابهم » (1).
هؤلاء المؤمنون ، وهم المنفقون لأموالهم في سبيل الله وطبيعي أن يكون جزاؤهم من الله جنات تجري من تجتها الأنهار خالدين فيها وأزواجاً مطهرة ويظلل كل ذلك رضوان من الله وهو غايتهم من الله وهو غايتهم في الدنيا والآخرة.
القرآن الكريم يتكلم مع الناس من خلال واقعهم العملي في حياتهم اليومية ، ولذلك فهو حينما يشوقهم إلى شيء إنما يعرض عليهم صوراً مألوفة لهم يتوخى من وراء ذلك أن يحفز مشاعرهم للوصول نحو هدفه المنشود.
وفي خصوص ما نحن فيه فإن القرآن عندما يشوقهم إلى الإنفاق يصور لهم فوائد من طريق الربح والفائدة الخارجية.
ذلك لأن النفس مجبولة على حب المال وتشويق في كل وقت إلى النفع والزيادة.
ولأن هذا المعنى يعيشونه في كل يوم فهم يألفون له عندما يمثل لهم به من خلال عرض قضية ، أو تشويق لشيء ، وبما أن الحياة العملية تعتمد بشكل رئيسي في
ص: 52
واقعها الخارجي على أمرين مهمين في طريق الكسب والانتاج ، وهما التجارة والزراعة.
وحيث أن لكل من هذين مفاهيمه الخاصة وصورة المنطبعة في الأذهان لذا نرى القرآن الكريم ، ومن هذا المنطلق أخذ يكلم الأفراد ويشوقهم إلى الإنفاق بعرض صورٍ مألوفة لديهم لتوصيل بها إلى الغاية المطلوبة له من الحث على البذل والسخاء.
( إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) (1).
هذه التجارة هي التي يقصدها عباد الله المؤمنون يدفعون المال لوجهه لأجله الوصول إلى غايتهم المحببة وهي رضا الله والتقرب إليه.
فهم يتلون كتاب الله بتفهم لما فيه ، ويقيمون الصلاة ويواظبون على أدائها.
(وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً) :
ينفقون مما رزقهم في السر والعلن يقصدون بذلك النماء الذي يحصل من هذه التجارة التي لا كساد فيها ، ولاتبور ، ولا يكتب له الخسران.
ولماذا تكسد ؟
أو لم تبور ؟
أو لماذا تلحقه الخسارة ؟
وطرف المعاملة هو الله ، وليس هو فرداً من البشر ، وليس هذا النوع من الكسب فيها يشبه الكسب السوقي الذي يؤمل فيه الربح كما هو متوقع فيه الخسران.
ص: 53
بل كسب كله ربح.
لا كسب يؤمل فيه الربح.
ونماء كله بركة لأن الضامن في هذه التجارة والطرف فيها هو الله سبحانه وهو الذي يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أنه غفور شكور.
ويأتي الجزاء هنا متدرجاً على ثلاثة مراحل :
(لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ) :
فلا يجدون في ذلك أي نقص ولا خسارة ، بل يوفيهم بما تعطيهم هذه الكلمة من معنى دقيق يدل على عدم وجود أي نقص في الحساب.
(وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) :
وهنا تتجلى الروعة في العطف والرحمة ليتبين الفرق بين المعاملتين المعاملة بين الأفراد أنفسهم والمعاملة بين الفرد وربه.
ان الله يرضى لنفسه أن يعامل عباده معاملتهم لأنفسهم ، بل لابد من حصول المايز بين المعاملتين.
معاملة يكون الإنسان طرفاً فيها لإنسان آخر.
ومعاملة يكون الله طرفاً فيها لعبد من عباده.
ففي الأولى نرى للحساب الدقيق مجالاً فيها ، وقد تجر المعاملة إلى نزاع وشجار بين الطرفين ، أو الأطراف حول مقدار قليل من المال.
أما لو كانت المعاملة بين الخالق ومخلوقه فإنه سبحانه بلطفه وكرمه يزيدهم من فضله وقد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله قوله :
« ما نقص مال من صدقة قط فأعطوا ولا تجبنوا » (1).
ولا يكتفي بذلك بل :
ص: 54
(إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) :
يغفر للعبد ذنوبه جزاء قيامه بهذا العمل الإنساني ، وهذا التقرب لوجهه وشكور على هذه الاريحية من المعطي وتحسسه بآلام غيره ، والشكر من الله يختلف عن شكر الإنسان.
إذا أن شكر البشر لا يتعدى عن الكلام المعسول وإظهار العطف واللطف ، وقد يتعدى إلى جزاء دنيوي سرعان ما يذهب ويتلاشى.
أما الشكر من الله فهو العطاء المتواصل والجزاء المضاعف ، وجنة أنهارها جارية ، بارك الله للعبد بهذه التجارة.
بعد أن صور القرآن للفرد النماء الحاصل من الإنفاق كنماء الكسب والتجارة بدأ يضرب له مثلاً يعيشه الفرد أيضاً في هذه الحياة ذلك هو مسألة الأرض والزرع هذا المنظر المألوف لكل أحد حيث يرى الفرد منا الزارع في الحقل يزرع ويسقي وينتظر ليحصل من وراء هذا الزرع النماء الذي يباركه الله.
لذلك جاءت الآيات الشريفة تقرب عملية الانفاق وحصول البركة فيه إلى الأذهان بهذا النوع من التشويق وكلاهما واحد يزرع الزارع ، وينتظر رحمة ربه ، وينفق المنفق ويتنظر عطاء ربه.
يقول سبحانه :
( وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (1).
(الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله) :
ص: 55
هذه العملية تماماً كمثل جنة بربوبة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين ، والربوبة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الانهار وعندما يصيبها المطر تنبت تلك الربوة فتؤتي ثمارها ضعفين بركة من الله في ذلك النتاج.
وكذلك في العملية الإنفاقية يضاعفها الله بركة منه على عبده.
فعن قتاده قال : ( هذا مثلٌ ضربه الله لعمل المؤمن يقول : ليس لخيره خلف كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حال ان اصابها وابل ، أو اصابها طل...)(1)
الطل: «الرذاذ من المطر أي اللين منه » (2).
وفي آية أخرى يقول الله تعالى :
( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (3).
وليس كل نماء يؤتي أكله ضعفين كما في الآية السابقة ، بل بعض النماء يتضاعف فيصل إلى سبعمائة كما تصرح به هذه الآية الكريمة فهي حبة واحدة أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة مائة حبة ، وطبيعي أن يكون ناتج كل حبة سبعمائة حبة ومثل ذلك أجر من أنفق.
فعن النبي صلی الله علیه و آله :
« ومن أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة » (4).
وفي حديث آخر : « ومن أنفق في سبيل الله ضعفت له نفقته الدرهم بسبعمائة،
ص: 56
والدينار بسبعمائة » (1).
(وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) :
فالقضية تعود إليه : وتناط بكرمه ولطفه فهو يضاعف لمن يشاء ولا حرج في ذلك عليه ولا ينقص من ملكه شيء ، وان من يبخل هو الذي يخالف الفقر ، وهو الإنسان اما الله فلا يخاف فقراً ، ولا نهاية لعطائه إذ لا حد لملكه ولا حد لعطفه.
( وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) :
وانما يضاعف لمن يشاء ولا يخشى الفقر لأنه واسع في عطائه واسع في رزقه واسع في فضله لا يعطي على قدر ما يصل إليه ، بل عطاء ثر ولطف عميم.
يقول سبحانه وتعالى :
( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ) (2) :
والقرض عملية شائعة على الناس يحتاج الإنسان إليها مالاً ، أو نقداً فيستقرض ما يحتاج إليه إلى أجل أو غير أجل ، وإذا زيد على القدر المستقرض شيءً فهو من الربا الذي حاربه الله ، ومنعه ، وتوعد عليه لأن كل قرض جر نفعاً إلى المقرض فهو ربا. هذا بين الناس.
وهذا القرض لو كان بين الفرد وبين الله فلا ربا بين العبد وربه لذلك جاءت الآيات تحبب إلى المنفق عمله فتجعل من عطائه إلى الفقير قرضاً منه إلى الله سبحانه ، ومن ذلك ينتج أن عملية القرض هذه تتألف من أطراف ثلاثة :
الطرف الأول : المنفق ، وهو الدائن.
الطرف الثاني : الله سبحانه ، وهو المدين.
ص: 57
الطرف الثالث : وهو الفقير ، المستفيد.
ولكن لو تساءلنا ما وراء هذا القرض من نفع إلى المنفق ؟ فإن الجواب سيظهر لنا من خلال الآيات الآتية.
وقبل أن نستعرض تلك الآيات لابد أن نقول : إن الإنسان ليقف حائراً ، وعلامات الاستفهام تأخذ عليه مسالك التفكير عندما يرى القرآن الكريم يكرر هذا الطلب من الله في موارد ستة ، وهو يطلب منهم بأن يقرضوه قرضاً حسناً ، ولهم عليه الجزاء الأوفر ، وهذا إن دل فأنما يدل بشكل واضح على مدى الاهتمام الذي يوليه الله لهذه العمليه الإنسانية.
فالله هو الذي أنعم على الإنسان فأعطاه المال ورزقه وكفل له معيشته وتفضل عليه - مع كل ذلك - نراه يعود ليجعل من نفسه مستقرضاً.
وممن ؟
من الذي وهب له المال واعطاه النعمة ، وهو المنفق.
ولمن ؟
الى الطبقات المحرومة الضعيفة.
ولماذا ؟
وكان بإمكانه أن يرزق الفقير من غير حاجة إلى مثل هذا القرض.
ولا بد لنا أن نتخطى ولا نعير لهذه الاستفهامات أهميه إذا عرفنا أن الله سبحانه يريد أن يشمل كلاً من الطرفين المنفقين ، والفقير برحمته وان استدعى ذلك أن يتحمل هو عبء العملية القرضية فهو الرحيم وهو الرحمن ، وهو الذي خلق هذا الخلق فكانوا عيالاً عليه.
خيرهم اليهم نازل.
وشرهم اليه صاعد.
ومع ذلك فهو يحوطهم برحمته ويكلؤهم برعايته.
ص: 58
أما ما يستفيده الطرف الأول ، وهو المنفق فأن الآيات الكريمة وعدته بالجزاءين الدنيوي والأخروي.
في الدنيا : ويتمثل في الآيات الكريمة :
(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً) (1).
(إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ) (2).
(إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ) (3).
وهذا هو الجزاء في الدنيا يضاعف له ما أعطاء بأضعاف كثيرة - كما في الآية الأولى - من الرزق ، وبذلك ليطمئن المنفق بأن ما ينفقه سيخلف عليه ، وسيرجع له ولكن بأضعاف كثيرة لأن الآية نفسها تعقب على هذه المضاعفة بقوله تعالى :
(وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)(4):
وإذا كان القبض والبسط في الرزق منه سبحانه ، وقد قال في صدر الآية بأنه سيضاعف للمنفق فهو وعد منه ووعده الحق وحاشا له أن يتخلف عما يعد به.
هذا هوالأجر في الدنيا.
وأما الأجر في الآخرة فقد اختلفت الآيات في طريقة الاخبار به ، ففي بعضها نرى أنها تعد بالمغفرة فقط حيث قال سبحانه :
(إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ) (5).
ص: 59
وليس هذا الجزاء بالشيء القليل حيث يحصل المنفق من وراء إنفاقه أن يغفر الله ذنوبه ، بعد هذا له من الله الشكر على ما قدم للمحرومين في هذه الحياة.
أما البعض الآخر : فأنها تطرقت لذكر الأجر من غير تفصيل لنوعية الأجر فقالت :
(إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) (1).
(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا) (2).
ولكن هذا الأجر يأتي في آيات أخرى وقد بانت نوعيته فقال سبحانه :
(وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) (3).
(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ * يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (4).
وهذا هو الجزاء الأخروي تعرضه الآيتان فيهما ما يحفز المنفق على الاسراع بهذا النوع من العطاء ليحصل على هذا النعيم الأبدي.
(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ) :
أي نور هذا الذي يلف هؤلاء المؤمنين فيأخذ اشعاعه بالأبصار ؟.
وأي نور هذا الذي يميزهم عن بقية الناس في ذلك اليوم ؟.
ص: 60
انه نور جللهم الله به وأضفاه عليهم !
وهل يكتفي العلي القدير بهذا التقدير ، وهذا القدر من الجزاء ؟.
ويأتينا الجواب واضحاً تضيفه تكملة الآية الشريفة في قوله تعالى :
(بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (1).
يناديهم المنادي ويبشرهم بهذه الجنات جزاء عملهم ، وقد شهد الله لهم بأن ذلك هو الفوز العظيم.
ويدلنا على أنه سبحانه سيضاعف العطاء لمن أعطى في سبيله ما صرح به في الآية التالية حيث قال سبحانه :
(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) (2).
(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا) :
والمحق هو الهلاك والاتلاف للشيء ، وفي المعاملة الربوية يتكفل الله بموجب هذا التصريح انه يمحق ذلك المال أو يستأصله ويتلفه لأنه مال لوحظت فيه الزيادة غير المشروعة فهو محق وهلاك له.
(وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) :
ولكنها في المعاملة التي تكون بين الله وعبده عندما يستقرض الله منه فأنه يربيها ويزيدها وينعشها ، وذلك لأن طلب الزيادة في القرض ان كان على حساب الغير وبين الناس أنفسهم فهو رباً لا يدعه الله حتى يمحقه.
وقد قيل للإمام الصادق علیه السلام :
« وقد يربى الرجل فيكثر ماله ، فقال : يمحق الله دينه وان كثر ماله » (3).
ص: 61
ولكنه لو كان على حساب الله وطلب مرضاته فهو الذي يتكفل بإنمائه ويبعث البركة فيه.
وقد روي عن النبي صلی الله علیه و آله انه قال :
« إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة فأربيها له كما يربي أحدكم فله حتى أجعلها له مثل جبل أحد » (1).
(وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) (2).
وقد فصلت الآية الكريمة بين مالين قصد من المعاملة بهما النماء والزيادة.
الأول : معاملة ربوية يكون أطرافها البشر أنفسهم.
الثاني : معاملة ربوية تجري بين العبد وربه.
وقد قالت الآية عن المعاملة الأولى أنها لا تربو أي لا تنمو ولا يباركها الله.
أما عن الثانية فقد قالت بأن الله يباركها ويضاعفها ، والسبب واضح ، ففي المعاملة الأولى تؤخذ الزياده من المستقرض لصالح المقرض ، وفي ذلك إنهاك لهذا الطرف وتفتيت للمال بواسطة القرض.
أما في المعاملة الثانية : فإن الزيادة يعطيها الله لعبده المنفق من غير أن ينقص من مال الله شيء ، وهذا هو النماء الحقيقي الباقي الذي تشمله بركة الله ، أما المال الذي يحصل من الربا فلا يكتب له التوفيق بل هو مال سحت يبغضه الله سبحانه.
ص: 62
وهذا النوع من التشويق تصرح به الآية الكريمة ، والأخبار الكثيرة حيث تخبر المنفق بأن الطرف في هذه العملية الإنسانية الطيبة هو الله لا الفقير لتصريحها بأن الله يأخذ الصدقات ، أو هو يتقبلها ، أو أن الصدقة تقع في يده أولاً ، ومن ثم ليد الفقير على اختلاف في العبارات التي وردت في الآية ، أو الأخبار إلا انها على اختلافها ترمز إلى معنى واحد ، وهو أن الفقير واسطة بين الله والمنفق فهذا يعطي وذاك يأخذ.
يقول سبحانه :
( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )(1).
وقد تضمنت هذه الآية الكريمة مطالب ثلاثة عطف احدهما على الآخر فكان الحكم في الجميع واحداً.
(أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ) :
وهذا هو المطلب الأول ، ولا مجال للشك في أن قبول التوبة من العبد مختص بالله وحده لتصريح الآية بذلك ، ولأنه هو الذي يغفر الذنوب صغيرها وكبيرها.
(وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ) :
ص: 63
وهذا هو المطلب الثاني وبحكم العطف في الآية لابد أن نقول : إن من يأخذ الصدقة من المنفق هو الله لأنه كما يقبل التوبه من عباده ، وان ذلك مختص به كذلك هو يأخد الصدقات.
(وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) :
وهذا هو المطلب الثالث حيث أخبر عن نفسه بأنه التواب ، وهو مبالغة في قبوله للتوبة ، وهو الرحيم بعباده فلا يستوحش العبد إذاً من ذنوبه إذا كان الغافر هو التواب الرحيم.
ولا يأس من الجزاء إذا كان آخذ الصدقة هو الله سبحانه ، وانها تقع بيده أولاً.
فعن جابر عن الإمام الباقر علیه السلام قال : « قال أمير المؤمنين علیه السلام تصدقت يوماً بدينار فقال لي رسول الله صلی الله علیه و آله أما علمت أن صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى تفك به من الحي سبعين شيطاناً ، وما تقع في يد السائل حتى تقع في يد الرب تعالى ألم يقل هذه الآية : (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ»(1).
وفي حديث آخر عن الإمام الصادق علیه السلام قال : « كان أبي اذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم إرتجعه منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل فأحببت أن أقبلها إذ وليها الله ...)(2)
وفي آخر ورد عنه (عليه السلام) (صدقة الليل تطفيء غضب الرب ، وتمحوا الذنب العظيم وتهون الحساب وصدقة النهار تنمي وتزيد في العمر) (3).
وفي أخبار أخر جاءت عن الإمام الصادق علیه السلام أيضاً : « ما من شيء إلا وكّل
ص: 64
به ملك إلا الصدقة فإنها تقع في يد الله تعالی »(1) .
وفي حديث آخر عن اللإمام الباقر علیه السلام قال :
« قال الله سبحانه تعالى : أنا خالق كل شيء وكلت بالأشياء غيري الا الصدقة فإني أقبضها بيدي حتى أن الرجل والمرأة يتصدق بشق التمرة فأربيها له كما يربي الرجل منكم فصيله وفلوه (2) حتى أتركه يوم القيامة أعظم من أحد »(3).
ولمذا إذا يتأخر المنفق ، أو يتقاعس عن القيام بمثل هذا التقديم لله والله هو الذي يأخذ منه ويوفي له حسابه.
وتنحوا آيات ثلاثة من القرآن نحواً جديداً في الحث والتشويق على الانفاق ذلك إنها أخذت تذكر الناس بأن يسارعوا إلى تقديم هذه المعونات إلى الفقراء ما دامت الفرصة حاصلة لهم وبإمكانهم أن يعملوا أعمالاً صالحة تكون لهم المخزون الاحتياطي ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وتحذرهم من مغبة اليوم الذي يقف الموت حائلاً بينهم وبين كل حركة لهم.
يقول سبحانه :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا
ص: 65
شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (1).
وفي آية أخرى :
(قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ) (2).
ذلك اليوم الذي تقف فيه الحركة التجارية فلا بيع ولا شراء ، ولا صديق يقف إلى جانب صديقه ، ولا شفيع يشفع لصاحبه.
ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، وقد بلغت القلوب الحناجر.
ذلك اليوم الذي ينادي من فاته الركب :
(قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ) (3)
فيأتيه الجواب : (كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا)(4).
أن القرآن يهيب بالإنسان أن يعمل صالحاً بإقامة الصلاة ، وهو الواجب الروحي وبالإنفاق وهو الواجب المعنوي قبل أن يأتي ذلك اليوم فتغلق بوجهه الأبواب ويواجه المصير من غير تدارك لما فات.
وهكذا نرى القرآن لا يكف عن ان يذكر الإنسان قبل فوات الأوان ، وتفويته الفرصة الذهبية فيقول تعالى في آية ثلاثة :
(وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ
ص: 66
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) (1).
وهذه الآية لا تختلف عن الآيتين السابقتين من حيث الاطار العام ، وهو أن الاسلوب القرآني يدعو فيها إلى تنبيه الإنسان إلى المبادرة إلى الانفاق من قبل أن تفوت عليه فرصة العمر ، ولكن الذي نلمحه من خلال هذه الآية الكريمة هو الطلب الذي يطلبه من فاتته الفرصة بعد الموت من ربه ليعود إلى الدنيا والغاية التي يريد تحقيقها من هذه العودة وهي قوله عزوجل :
(فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) :
ان هذا التركيز من مثل هذا الإنسان على التصديق وبه ليكون من الصالحين يعطينا أهمية ما يكشف له في ذلك العالم ، وهو يرى آثار الصدقة بما فيها الزكاة أو الانفاق المطلق في سبيل الله لذلك يأخذه الندم على عدم القيام بها ، وإنه لم يقل لأعمل العمل الفلاني أو أي عمل من الأعمال ، بل صرح بالتصدق بل وأخذ يعض يديه ندماً على ما فرط في حياته من عدم الالتفات إليه ... ولكن هيهات فقد انتهى كل شيء وعادت النفس إلى ربها :
إما مطمئنة راضية.
وإما نادمة حيث لا ينفعها الندم والأمر يومئذ لله وحده.
وقد جاء أنه سأل رسول الله صلی الله علیه و آله أي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا، وقد کان لفلان » (2).
ص: 67
ومن ثنايا الأخبار نرى كثيراً منها تشوق المنفقين ، وتذكر للصدقات والاحسان إلى المحتاجين خصائص كثيرة البعض منها تصرح بفوائد تعود على المنفق في الدنيا ، والبعض الآخر تنفع المنفق فيما يخص آخرته :
فمن القسم الأول : ما جاء عن النبي صلی الله علیه و آله قوله :
« استنزلوا الرزق بالصدقة » (1).
وفي حديث عن الإمام الباقر علیه السلام : « أن البر ، والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة من السوء » (2).
وعنه علیه السلام في حديث آخر :
« وان الله يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة الف فما زاد » (3).
ويقول الإمام الصادق علیه السلام : « إن الصدقة تقضي الدين وتخلّف البركة » (4).
وعنه علیه السلام ايضاً : « ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا الا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده » (5).
ص: 68
وعن الإمام الرضا علیه السلام : « انه كان في بني اسرائيل قحط شديد سنين متواترة ، وكان عند امرأة لقمة خبز فوضعتها في فيها لتأكلها فنادى سائل : يا أمة الله الجوع فقالت المرأة : أتصدق في مثل هذا الزمان فأخرجتها من فيها فدفعتها إلى السائل ، وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء فجاء الذئب فحمله فوقعت الصيحة فعدت الأم في أثر الذئب فبعث الله تبارك وتعالى جبرائيل فأخرج الغلام من فم الذئب فدفعه إلى أمه ، فقال جبرائيل : يا أمة الله أرضيت ؟ لقمة بلقمة » (1).
ويقول النبي صلی الله علیه و آله :
« داووا مرضاكم بالصدقة » (2).
ومثل هذا جاء في كثير من الإخبار ، وقد عقّدت كتب الحديث أبواباً عديدة لذكر الأحاديث التي صرحت بهذه الفوائد التي يجنيها المنفق من وراء احسانه وتصدقه.
ولماذا نستبعد ونستكثر مثل هذه الفوائد على الصدقة ؟
فالقضية قضية تعويض من الله سبحانه لعبده المنفق يعوضه بهذه المزايا الدنيوية جزاء هذا التفقد الذي يصدر منه ونتيجة هذا التعاطف من بعض الناس مع الآخرين.
وأما القسم الثاني : فقد روي عن النبي صلی الله علیه و آله قوله :
« أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظلله » (3).
وعن الإمام أمير المؤمنين علیه السلام قال :
« الصدقة جُنة من النار » (4).
وقد جاء عن الإمام الباقر علیه السلام قوله :
« ولأن أعول أهل البيت من المسلمين وأشبع جوعهم ، وأكسو عورتهم ، وأكف وجوههم عن الناس أحب اليَّ من أن أحج حجة ، وحجة حتى أنتهى إلى عشر مثلها ومثلها حتى
ص: 69
انتهى إلى سبعين » (1).
بهذه النفسية العالية يواجهنا الإمام أبو جعفر الباقر علیه السلام وبهذا القلب الذي تتفجر منه الرحمة من كل جوانبه يتجه الإمام ليدخل بيتاً من بيوت المسلمين ليعول من به ، وبذلك يخفف عنهم أزمات الفقر.
وطبيعي أن يكون هذا العمل أحب إلى الإمام علیه السلام من سبعين حجة ، والسبب في ذلك أن الحج ينتفع به الشخص نفسه لما يحصل عليه من ثواب ، وأما إعالة البيوت الفقيرة فإن النفع فيها يعود إلى الشخص نفسه بالثواب ، وإلى الآخرين بانتشالهم من براثن الشبح المرعب وهو الفقر ، وبذلك يأمن المجتمع من شرور هؤلاء المحرومين ، ولذلك كان هذا العمل أحب إلى الإمام علیه السلام من الحج المتكرر.
على أن الإمام وهو العالم بكل الخصوصيات لو لم يعلم أن في الإعالة المذكروة الثواب الذي يزيد على الثواب الذي يحصل من سبعين حجة لما كان ذاك أحب إليه من هذا.
ومن هذا المنطق نعلم أن الثواب الذي يحصل عليه المنفق لا يحد بحد طالما كان مصدره من وصف نفسه بالرحمن الرحيم. الفقير هدية الله إلى الغني :
بهذا النص جاء الخبر عن الإمام محمد الباقر علیه السلام حيث قال :
« الفقير هدية الله إلى الغني فإن قضى حاجته فقد قبل هدية الله وان لم يقض حاجته فقد رد هدية الله » (2).
الفقير هدية :
ولكن ممن ولمن ؟.
ممن : من الله.
ولمن : إلى الغني.
ص: 70
وليحاسب الغني نفسه ، وهو يقف وجهاً لوجه أمام هدية الله - وهو هذا الفقير - يأتي ليطلب منه ما يسد حاجته فهل يقبل هذه الهدية أم يردها ؟.
ولكن رد مثل هذه الهدية بعيد عن المؤمنين الذين يقدمون كل غال ونفيس في سبيل التقرب إليه جلت عظمته.
ولم يقتصر التشويق والحث على الإنفاق على الاغنياء ليقوموا بهذا العمل الإنساني بل تعداه إلى غير هؤلاء من الناس فقد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله :
« من مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيئاً » (1).
إن النبي الأكرم يريد من وراء هذا الحديث أن يطمئن الغني بأن دخول الشخص الثالث بينه وبين الفقير لا يوجب تقليلاً للثواب والأجر.
ولماذا ينقص من أجره ، والمعطي هو الله ؟.
ولو كان الإنسان هو المجازي لكان لمثل هذا الحساب احتمال أما وان الله هو الذي يرسل الهدية وهو الذي يتقبل العطاء ويأخذ الصدقات قبل الفقير فلا مجال لمثل هذا الحساب.
وبعد كل هذا فإن الله هو الذي يستقرض من الغني ما ينفقه فلا بعد اذاً لو كان الأجر محفوظاً لكليهما المنفق ، ومن توسط في اخراج المال إلى الفقير.
اما الإمام الصادق علیه السلام ، فقد وسع دائرة الثواب لتمشمل أكثر من واحد لو تعدد الوسطاء بين الغني ، والفقير حيث جاء ذلك في حديث عنه قال فيه :
« لو جرى المعروف على ثمانين كفاً لأجروا كلهم من غير أن ينقص عن صاحبه من أجره شيئاً » (2).
ص: 71
وقد يستغرب الإنسان وهو يردد فقرات هذا الحديث في قوله :
« لو جرى المعروف على ثمانين كفاً » ... الخ.
بهذا العدد وبهذه الكثرة ، وهل توجد هكذا عملية يحدث فيها أن يصل رقم الوسطاء إلى هذا الحد.
وللجواب عن ذلك نقول :
ان الاستغراب المذكور يزول لو لاحظنا ما جاء عن النبي صلی الله علیه و آله في مثل هذا الموضوع حيث قال :
« من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف انسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل. وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعملون »(1).
وقد يوجه البعض هذا التصعيد في الرقم فيعتبره للمبالغة ليفهم بأن المنفق أجره محفوظ ، ولو تعدد الوسطاء ، وكانوا من الكثرة بمكان.
ولكن الذي نراه أن الحديث لا مبالغة فيه من حيث الموضوع وهو حصول الأجر للوسطاء ، وان تعددوا.
نعم قد يكون هذا الرقم جاء للمبالغة من حيث العد والعدد إذ حصول مثل هذا العدد من الوسطاء قد يكون نادراً في قضية إحسان من شخص لآخر ، وإلا فلو فرضنا انه حصل مثل ذلك ، أو أقل منه فإن الأجر يكون محفوظاً لهم ، كما يقول النبي صلی الله علیه و آله :
« وما عند الله خير وأبقى للذين أنفقوا وأحسنوا » ولا لوم على من يستكثر مثل هذا الجزاء وهو ينظر إلى الأجر بمنظار كونه المعطي انسان ومخلوق ضعيف أما لو نظرنا إلى القضية بمنظار كون المعطي هو الله الذي لا حد لعطائه وفضله وانعامه فالمسألة تهون بل تتضاءَل في رحاب لطفه كل هذه الوساوس والشكوك
وقد جاء في فقرات من أدعية أهل البيت علیهم السلام قولهم : « يا من الكرم من صفة
ص: 72
أفعاله والكريم من أجل أسمائه »(1).
ومن التشويق إلى الإنفاق ينتقل القرآن الكريم إلى الطريق الثاني في سلوكه مع الذين لا ينفقون من أموالهم في سبيل الله وبه يتوخى أن يستنهض هممهم لهذا المشروع الإجتماعي الحياتي ، وهو الإحسان بالبذل.
والآيات في هذا الخصوص تبدأ بفتح حوار مع الموسرين ومُناقشتهم في عدم استجابتهم لنداء الضمير ، وإسعاف المعوزين وتنبيههم إلى أن ذلك لا يضر بالله وإنما تعود آثاره وخلفياته السيئة على أنفسهم ، وعليهم أن يتبدروا حالهم ما دامت الفرصة مواتية وقبل أن يبعد الزورق عن الساحل وبذلك يتلاشى الضوء الأخضر ، وحينئذ فلا ينفع الندم.
(هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ) (2).
حوار هادئ يتضمن مناقشة دقيقة يجريه الله مع من يشح على نفسه يمنعها من فعل الخير فلا يساعد من هو في حاجة إلى المساعدة.
(هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
من خلال هذا المقطع تتجلى روعة الحوار في تعبير الآية بقوله ( تدعون ) ولم يقل ليفرض عليكم ، يكلفكم ، أو يأمركم ، وما شاكل من هذا النوع من العبارات التي تدل على الاستعلاء ، بل افتتح الله وهو العالي الحوار معهم بهذه الدعوة المفتوحة والأسلوب الهادئ الرقيق وبدلاً من أن تكون التلبية لهذه الدعوة بالإيجاب والإسراع لكسب الخير ونيل الجزاء فإن الاستجابة منهم كانت عكسية ، وإذا بالواقع العملي لتلك الدعوة يتضح من خلال الفقرة التالية :
ص: 73
(فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ) :
ومن خلال بخله يتوقف عن تلبية هذه الدعوة الخيرة بجمع الشمل وبث روح التعاون بين الجميع.
ويبدأ الحساب :
(وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) .
لا على الله فأن عدم الاستجابة معناها الحرمان من الأجر والثواب في الآخرة وبذلك يخسر الصفقة وتفوت منه الفرصة.
أما الله فلا يفوته بهذا الامتناع شيء ذلك لأنه يصرح قائلاً :
(وَاللَّهُ الْغَنِيُّ ) :
فلا حاجة له بالمال ، وهل يحتاج إلى المال من كان مصدر العطاء إلى الناس ؟
وما يأتي على لسان الآيات الكريمة عندما تصرح بأن الله يستقرض من الناس أو يطالبهم بالإنفاق ، فإنما هو لإيصال النفع اليهم قبل الفقراء نظراً إلى أن ما يصل إلى المحسن يضاعف أجره ، ويزيد على مقدار ما ينفعه ، وهذا اشارة إلى أن معطي المال أحوج إليه من الفقير الآخذ فبخله بخل على نفسه ، وذلك أشد البخل قال مقاتل : إنما يبخل بالخير والفضل في الآخرة عن نفسه (1).
(وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ) :
الفقراء إليه سبحانه في كل صغيرة ، وكبيرة في الدارين الدنيا والآخرة.
في الحياة الدنيا : إلى مقوماتها.
وفي الآخرة : إلى ثوابها وجزائها.
وإذا كان الغني هو الله ، وهو القادر ، والرازق ، والقابض ، والباسط , والناس هم الفقراء إليه فعندما يطلب الغني الواقعي - الله - من الغني الصوري - المعطي -
ص: 74
فإن هذا الطلب لا يعود بالنفع إلى الأول بل إلى الثاني لاحتياج هذا إلى الجزاء والثواب دون الأول إذ من الواضح أن فاقد الشيء لا يعطي كما تقرره القاعدة المعروفة.
وقد أكد القرآن الكريم على هذا المعنى في آية أخرى قال فيها :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (1).
ومرة أخرى تؤكد هذه الآية ما افادته الآية السابقة من غنى الله وفقر العبد اليه ، ولكن في التكرار معنىً جديد تفيده الآية وقد نبهت عليه وبه تمتاز هذه الآية عن سابتقها.
ان هذه الآية أعطت صورة مميزة لغنى الله عن غنى البشر ، وقد جاء بذلك بوصف الغني بأنه (الْحَمِيدُ) .
« أن تذييل الآية بصيغة الحميد للإشارة إلى انه غني محمود الأفعال إن اعطى وإن منع لانه اذا اعطى لم يعطه لبدلٍ لغناه عن الجزا ء والشكر ، وكل بدل مفروض.
وإن منع لم تتوجه إليه لائمة إذ لاحق لاحد عليه ولا يملك منه شيء » (2).
وهذا بعكس ماعليه الغني من بني الإنسان فإنه ان أعطى فإنما هو لبدل ليشكر وليمدح ، وإن منع توجه عليه اللوم اذ في أمواله حق معلوم للسائل والمحروم ، فبتقصيره وعدم الإنفاق يتوجه عليه اللوم.
وفي تأنيب آخر ضمن آية كريمة أخرى عرضت لنا صورتين لشخصين منفق وبخيل ، وما يجري على كل منهما :
( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
ص: 75
وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ) (1).
من خلال هذه المقابلة الدقيقة التي يجريها القرآن الكريم بين شخصين :
أحدهما : أعطى واتقى.
والآخر : بخل واستغنى.
وما لكل منهما من أجر وما سيجري عليه.
نرى الأول : فقد وعده الله بقوله ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) ، وسيجعل له حياة هادئة رغيدة ميسرة واليسر هنا عام لا يقتصر على شكل خاص في الحياة بل يشمل جميع مراحل حياته الجانب المالي وغيره نتيجة لاستجابته لنداء الله وقيامه بما تفرضه عليه الوظيفة الإجتماعية.
وأما الثاني : فقد وعده الله على العكس مما وعد به الأول ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ) حياة معسرة ومعقدة يجد فيها أنواع العسر والضيق والكمد يتلكأ فيها :
يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام : « فأما من أعطى مما آتاه الله واتقى وصدق بالحسنى أي بأن الله يعطي بالواحد عشراً إلى كثير من ذلك ، وفي رواية أخرى إلى مائة ألف فما زاد فنيسره لليسرى قال لا يريد شيئاً من الخير إلا يسره الله له ، وأما من بخل بما آتاه الله واستغنى وكذب بالحسنى بأن الله يعطي بالواحد عشراً إلى أكثر من ذلك ، وفي رواية أخرى إلى مائة الف فما زاد فنيسره للعسرى قال لا يريد شيئاً من الشر إلا يسره الله له ، وما يغنى عنه ماله إذا تردى أما والله ما تردى من حبل ولا تردى من حائط ، ولا تردى في بئر ، ولكن تردى في نار جهنم » (2).
أما ترديه في نار جهنم فإن الله سيخلي بينه وبين الأعمال الموجبة للعذاب والعقوبة وحينئدِ فلا بد من ترديه وسقوطه بالأخير في جهنم.
ص: 76
وأخيراً نقف بين يدي آية ثالثة نستعرض من خلالها تأنيباً وتوبيخاً يشتمل على نوع من التصحيح لمفاهيم البعض الخاطئة حيث ينظرون إلى المال باعتباره المقياس لكرامة الإنسان وإهانته يقول تعالى :
(فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ * كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ * وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) (1).
وعبر هذه الآيات يقف القرآن الكريم ليصحح للناس مقاييس الاكرام والتعظيم والإهانة والتحقير.
يتصور الإنسان أن المال منعاً وعطاءً من قبل المعطي هو مقياس الاكرام والاهانة - وعى سبيل المثال - فهو عندما يرى الله ينعم عليه من نعمة يعتبر ذلك مظهراً من مظاهر الأكرام ، وعندما يقتر عليه الرزق تثور ثائرته ويتجهم ، ويعتبر ذلك اهانة له من الله أو من غيره.
المهم هو العطاء والمنع في نظره.
ولكن الحقيقة تأتي مشرقة تتجلى بهذا النوع من التوبيخ والتأنيب تواجه به الآيات الكريمة الإنسان ليبقى درساً على مرور الزمن.
ان القرآن يريد أن يقول لهم :
كلا ليس هذا هو المقياس الحقيقي للأكرام والإهانة كما تتصورونه وان ما تبنون عليه واقعكم الحياتي إنما هو محض اشتباه وخطأ.
فالانسان عندما يرزق أو يمنع في كلتا هاتين الحالتين إنما هو مورد اختبار وامتحان.
يرزقه ليرى شكره.
ص: 77
ويمنعه ليرى صبره.
ومن وراء ذلك وفي كلتا المرحلتين يجازيه بالنعيم أو بالجحيم.
وصحيح ان مظاهر الأكرام بالإنعام والعطاء.
ولكن الاهانة ليست بتقدير الرزق والمنع ، بل الاهانة يستحقها الفرد لعدم قيامه بما يفرضه عليه الواجب الإجتماعي العام اتجاه من هو ضعيف.
وتبدأ الآيات في ختام المطاف تعرض نماذج تتجسد فيها الحاجة إلى الغير والتي بتركها يستحق الإنسان الإهانة وعدم التقدير :
(كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ* وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) .
(كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) :
عدم اكرام اليتيم نموذج من نماذج اهانة الإنسان المتمكن للطبقات الضعيفة المحرومة ذلك الإنسان الذي اعطاه الله وأنعم عليه فلم يراع تلك النعمة ليكفي اليتيم - وعلى سبيل المثال - من التكفف والتسول.
تقول بعض المفسرين معلقاً على هذه الفقرة من الآية : « والمعنى أن الاهانة ما فعلتموه من ترك اكرام اليتيم ومنع الصدقة من الفقير لا ما توهموه » من ان المقياس هو ما لو قدر الله على أحدٍ من العباد (1).
وقد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله قوله :
« أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى » (2).
هذا هو الكلام الذي جعل كافل اليتيم مع النبي صلی الله علیه و آله في الجنة ، وطبيعي أن يكون في قباله من ترك اليتيم ولم يرعه ولم يعط حقه.
ص: 78
وقد حث القرآن الكريم في آيات أخرى على اطعام اليتيم وجعله من الأسباب الموجبة لاقتحام العقبة التي تقف بين الإنسان وبين وصوله إلى الجنة فقال سبحانه :
( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ) (1).
ويوم ذي مسبغة : أي يوم المجاعة فمن أطعم يتيماً من ذي قرابته - وليس معنى ذلك تخصيص الاطعام به ، بل هو من باب الزيادة في الأجر لأنه رفق باليتيم وصلة للرحم - كان ذلك موجباً من موجبات اقتحام العقبة الكؤد.
وفي الحديث عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله :
« من أشبع جائعاً في يوم سغب ادخله الله يوم القيامة باباً من أبواب الجنة لا يدخلها إلا من فعل مثل ما فعل » (2).
(وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) :
أي لا يحث بعضكم بعضاً على هذا اللأمر ، وهو نموذج ثانٍ من نماذج الأهانة حيث يتركون المسابقة إلى اطعام المسكين المعدم يتركه من عنده ، وفرة من المال يغالب آلام الجوع في يوم مسغبة قال عنه القرآن.
(أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) :
هذا المسكين الذي لواه الجوع فألصق بطنه بالتراب من شدة جوعه يبقى يتحمل هذه المجاعة وفي نفس الوقت يبيت جار له وقد أتخم من الأكل لا يشعر بما يفرضه الواجب أزاء هذه الطبقات المنكوبة.
وهذا مقياس من مقاييس الفقر.
ونبقى نحن والفقرتين الباقيتين من هذه المقاييس.
ص: 79
(وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) :
وقد جاء في التفسير أن أكل التراث أكلاً لّماً بمعنى الأكل من غير تروٍ لما يأكل من خبيث وطيب ، أو أنه يأكل ماله ومال غيره.
وتحبون المال حباً جماً شديداً ، ولا تفكرون ان هذا المال سيكون وبالاً عليكم إذا جمعتموه ولم تعطوا حق الفقير منه.
وهذا هو الطريق الثالث الذي يسلكه القرآن الكريم مع الذين يبخلون بالمال على غيرهم من المحتاجين انه طريق الترهيب والتخويف من عواقب هذا البخل وهذه الشحة.
وقد عرضت الآيات هذا المعنى على نحو التدرج من اعطاء صور مخففة عن العذاب وأخرى مشددة ، أو بالأحرى اتخذت طريقين إجمالياً وتفصيلياً ، فأجملت آية وفصلت أخرى.
أما الآية المجملة فهي قوله سبحانه :
(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (1).
ويبدأ الحوار بقلب المفاهيم التي بنى عليها البخلاء نظرياتهم ، فالبخيل يتصور أن عدم الإنفاق وجمعه للمال إنما هو رصيد يتمتع به في كل وقت ويدخره إلى اليوم الأسود ، ولكن الآية الكريمة تقلب له هذا المفهوم وتبين له الخطأ الذي بنى عليه نظريته.
(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ) :
وتكمن نقطة. الخطأ في هذا التصور الذي يوصله إلى النتائج العكسية فهم
ص: 80
يتصورون ان جمع المال خير لهم لأنهم يكنزونه ، ولا يبعثرون به هنا وهناك.
ولكن ذلك شر لهم ووبال عليهم لأنهم :
(سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) :
ان هذا المال الذي بخلوا به وشحت به نفوسهم الرذيلة سيكون طوقاً من نار تقلد به رقابهم في يوم القيامة.
ثم ما هذه الشحة بالمال ، ولماذا هذا البخل ، والتلكؤ في اسعاف المعوزين ؟.
وهذا المال مال الله ، وليس لهم منه الا ما يساعدهم على ادارة الحياة.
ففي البداية هومال الله وقد تفضل به عليهم ولله ملك السماوات والأرض يهب من ملكه لعباده ما يشاء ، ويمنعه ممن يشاء.
وفي النهاية سينقل ما جمعه من حلال وحرام لوارثه ، ولا يأخذ منه شيئاً عدا ملفوفة من القماش البسيط يكفن بها ويستر بها جسمه ، وسيكون ضيفاً على « حفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم » (1).
ولم تزد الآية الكريمة لذكر الجزاء على أن ما بخلوا به من المال سيكون طوقاً في رقابهم لا أكثر.
ولكن هذا التخويف يتطور في الآية الثانية فيعرض صورة أشد وخزاً فتظهر معالمه من خلال الفقرات التالية في قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ) (2).
ص: 81
أي منظر تتحدث عنه هذه الآية الكريمة وأي انسان لا يتقزز وهو يشاهد هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة يعذبون بهذه الصورة الموحشة ؟.
ورويداً مع الآية الكريمة لنسير معها ولنقف عند مقاطعها لنستوعب ما تحمله بين طياتها من صور الترهيب والتخويف.
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) :
والإنفاق في سبيل الله عنوان عام يشمل الإنفاق بنوعيه الإلزامي كالزكاة والكفارات والتبرعي كالصدقات.
وقد بدأت الآية بالاخبار عن جزاء هذا الكنز وعدم الانفاق فأعطت صورة موجزة ، وقد مهدت بذلك الأذهان لصورة فصلت بها نوعية العذاب.
أما الايجاز فقد جاء من خلال قوله تعالى :
(فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) .
أما ما هو ذلك العذاب الذي وصفة القرآن بأنه (أَلِيمٍ) ؟ ويأتي الجواب التفصيلي لعرض صورة هذا النوع من العذاب الأليم.
(يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ) :
وهل يحمى على نفس الأموال الذهب والفضة ، والتي كنزت ، ولم تنفق أم انها تجمع فتكون صفائح ، ويحمى عليها كما جاء ذلك في حديث عن النبي صلی الله علیه و آله أنه قال :
« ما من عبد له مال ، ولا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة صفائح يحمى عليها في نار جهنم » (1).
وعلى كل حال ليس تحقيق ذلك بمهم ، بل المهم هو معرفة المراحل التي تلي هذه العملية بعدما يحمى عليها ، وقد أوضحت الآية ذلك في قوله عز وجل:
ص: 82
(فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ) :
وهي أهم أعضاء البدن وأبرزها تكوى بتلك الصفائح ، أو بتلك الكنوز الذهب والفضة المحماة ، وقد جاء عن رسول الله صلی الله علیه و آله في تكملة الحديث المتقدم :
« وتكوى بها جبهته ووجهه وظهره وحتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون » (1).
وبعد ذلك تأتي الآية الكريمة على ختام هذا الحوار الترهيبي فتقول :
(هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) :
وقد جاء في التفسير أن هذا القول يخاطبون به في حالة الكي والاحراق.
هذا ما كنزتم ومعناه ، هذا جزاء ما كنزتم لأنفسكم ، وكنتم تتخيلون أنه خير لكم وإذا به شر لكم ، وحيث تصل الآية إلى هذا الختام يسدل الستار على تلك الأجسام العفنة بمنظرها البشع ، وصوت من وراء الغيب يوعدهم قائلاً :
(فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) .
شروط الإنفاق :
الإسلام عندما يقوم بهذه الحملة الاعلامية الواسعة لموضوع الإنفاق من خلال الآيات والأخبار وتشويق الأفراد وحثهم على التسابق إليه لا يقصد من وراء ذلك اعطاء الفقير المال وانعاشه مادياً وتخليصه من ويلات الفقر فقط ، بل يريد ذلك - وفي الوقت نفسه - ان يجعل من هذه العملية قضية اصلاحية لكلا الطرفين المعطي والفقير.
المعطي : ليهذب نفسه ويصقلها ويروضها على فعل الخير والشعور بأن ما اعطاه الله من مال ليس له فقط ، بل له وللآخرين عبر رصيده وتملكه.
فهو يريد من صاحب المال ان يبقى دائماً بجانب الآخرين يتحسس آلامهم ،
ص: 83
ويعيش مشكلاتهم ، كما لو كانت قد حلت بأسرته البيتية.
وأما الفقير : فليفهم بأن هذا الاهتمام به لسد جوعه ، وان يملأ ما في بطنه من فراغ فقط بل ليشعره بأنه لم يترك في هذه الحياة وحيداً يعاني لوحده الأنواء والهزات التي تعاكس سفينته الصغيرة ، وهو يمخر بها وسط أمواج الحياة العاتية بل هناك من يقف إلى جانبه ويمد له الحبل ليلقي به على الساحل فينجيه مما هو فيه.
إنه الإسلام يريد من الفقير أن لا ينظر إلى الغني نظر المعدم إلى الملئ فقط بل نظر الصديق إلى الصديق نظر الإنسان الذي يتحسس بآلامه ويشعر بضيقه ليكون ذلك درساً له لو ضحكت له الدنيا وتحسنت حالته المادية فأصبح ملياً كالآخرين فيسير على نفس الخط الذي سار عليه يداً بيد مع المعطي وبذلك يتحقق التكافل الاجتماعي من الطرفين كما نبهنا إلى ضرورته فيما سبق.
ان هذه النقطة الدقيقة يعير لها القرآن أهمية بالغة ، وقد أكد عليها عبر آيات عديدة جاء منها قوله سبحانه :
( أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى * فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ) (1).
فالقضية ليست قضية مال يشبع بها الغني بطن الفقير بل قضية كرامة واعتبار.
قضية التحسس بآلام اللآخرين.
قضية الادوار التي مربها الإنسان لو قدر أن كان يتيماً فقد أباه في الصغر.
أو سائلاً حيث كانت الضروف قست عليه فيما سبق فكما عطف الله عليه فيهأ له من ينحو عليه ، ومن قابله بلطف وهو يملأ كفه من المال ، فلا بد أن يحذو نفس الطريقة التي عومل بها يوم كان يتيماً أو فقيراً.
ولو لم يكن قد مر بهاتين المرحلتين فليحسب للدنيا حسابها فيتصور اليوم الذي قد يمر به أولاده لو فقدوا كافلهم وهم صغار ، أو ليضع أمامه الظروف التي قد
ص: 84
تلجئه لأن يمثل نفس الدور الذي يقوم به الفقير حينما يلجأ إليه فيسلب منه تلك النعمة ويكون هو ضيفاً على الطرق والأبواب يسأل هذا ويتكف من آخرين.
وإذاً فإلى الانعاش المالي من الاغنياء لابد من رعاية الجانب الآخر المتمثل بالانعاش المعنوي ليجد اليتيم من رعايته ما يسببه ذل اليتم ، وهو في كنفه ، وليشعر الفقير إنه لا يمد يداً للغني وهو فقير بل إلى أخ يسعف أخاه ، كما يلجأ المريض إلى الطبيب لينقذه من براثن المرض.
وإذا كانت عملية الانفاق درساً تهذيبياً أكثر من كونها مساعدة مالية فلا بد إذاً لهذا الدرس من شروط تتناسب ، والغاية التي حشد الشارع المقدس لها هذا القدر من الآيات ، والاخبار الكريمة.
الإنسان الكامل هو الذي يجعل رضا الله والتقرب إليه هو الغاية التي يقصدها من وراء كل عمل يقوم به في هذه الحياة ... ذلك لأن ما كان لله يبقى ويكتب له النمو والبركة أما ما يقصد به غير وجه الله ، ولم يكن في سبيله فيذهب جفاء.
ثم ليقف الإنسان وليقارن بين من ينظر أجره منه :
من الله القادر الرازق ؟.
أم من انسان مثله عاجز ؟.
ومرة أخرى نقول أن اشتراط كون الإنفاق لوجهه وابتغاء مرضاته إنما يأتي في صالح المنفق قبل الفقير لأن الله يدعوه لأن يركز علاقته معه لتكون أعماله خالصة له فيجازيه بمايستحقه على ذلك ويضاعفه ، وبذلك ينال خير الدنيا والآخرة.
ولذلك رأينا الآية الكريمة ، والأخبار العديدة - فيما تقدم بيانه - تشوق المعطي بأن ما يصل ليد الله قبل الوصول إلى يد الفقير.
وهذا - كما قلنا - معنى كنائي يرمز إلى أن ما يقدمه الإنسان إلى الفقير إنما يقدم
ص: 85
لله بطلب مرضاتها - والفقير طريق يوصل إلى هذه الغاية الرفيعة لذلك كان الشرط الأول للإنفاق إذا أراد المعطي ان يزكوا ماله وينمو ليحصل من وراء ذلك الثواب الأخروي أن يكون ما يقدمه لله وفي سبيله لا لغرض آخر من الرياء ، أو التماس الشهرة ، أو تسجيل يد على الفقير ليكافئه على هذا اليد فيرد عليه جميله بخدمة يقوم بها تقديراً لعمله.
(وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (1).
والقضية تأخذ مسارها بشكل طبيعي فإن هذا النماء الذي يرجى حصوله مضاعفاً مصدره الله سبحانه ، وإذا كان مصدره الله فلا بد أن يكون العطاء بداعي التقرب اليه وابتغاء مرضاته.
وأما لو كان في سبيل غيره فما معنى أن يتوقع المعطي الأجر من الله وهو يعمل لغيره ؟
ويأتي هذا المعنى واضحاً في آية اخرى حيث يقول سبحانه :
(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) (2).
وهذا التدرج في الآية الكريمة هو الذي يوضح مسيرة الإنسان العطائية وكيف يجب أن يتبع هذه التعاليم القرآنية.
فما ينفقه من خير فلنفسه وهذه هي النقطة الأولى ، لأن المعطي هو الذي يحصل الثواب والأجر في الدارين ، ولكن ذلك الانفاق لابد أن يكون لابتغاء وجه الله وهذه هي النقطة الثانية ، وإلا فلا نحصل على النقطة الأولى وهي الأجر والثواب.
ص: 86
وبعد ذلك ليعلم المعطي ان ما ينفق من خير على النحو الذي بينته الآية يوف اليه وهذه في النقطة الثالثة.
أما لو ضربنا كل ذلك عرض الجدار وكان العطاء لغير الله فإن على المعطي أن يذهب لمن قدم له وليأخذ منه جزاءه وقد جاء في كتب الاخبار الواردة عن أهل البيت علیهم السلام بأن المرائي في عمله ليلتمس أجره ممن عمل له.
(وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (1).
لقد تعرضت الآيتان إلى الحديث عن قسمين من الناس ، أو فريقين ما شئت فعبر.
أحدهما : جعل الانفاق في سبيل الجهاد ، أو في سبيل الخير لاغراضه الشخصية ولم يكن لوجه الله.
أما الآخر : فقد كان الإنفاق عنده وسيلة للوصول إلى مرضات الله والتقرب إليه.
فقالت عن القسم الأول :
(وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا) :
والغرامة ما يخسره الرجل وليس يلزمه لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين رياءً لا لوجه الله عزوجل وابتغاء المثوبة عنده.
وهؤلاء جزاؤهم نتيجة انفاقهم لغير وجه الله لأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين أن :
(عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ)
وعليهم تدور الدائرة يبتلون بنفس ما كانوا يدبرونه للمسلمين من سوء وما
ص: 87
يعدونه لهم من عقبات .
أما القسم الثاني فقد قالت الآية الكريمة عنهم :
( وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ )
وهؤلاء هم المؤمنون بالله وبما أخبر عنه من يوم القيامة والجزاء وما يترتب على ذلك من غير شك وريب ، وقد أعطت وصفاً دقيقاً عنهم عندما ينفقون فقالت :
(وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ)
ولنقف قليلاً مع الفرد من هؤلاء لنرى كيفية انفاقه وما يقصد من وراء هذا العطاء.
أولاً : عندما ينفق تكون غايته التقرب إلى الله عز وجل ، ويجعل من عمله هذا وسيلة لنيل مرضاته فقط.
ثانياً : انه عندما ينفق يطلب من النبي صلی الله علیه و آله أن يدعوا له بالخير والبركة ليكون هذا الدعاء أيضاً وسيلة أخرى للتقرب إلى الله والركون إليه.
وهنا تواجه الآية هؤلاء المؤمنين بأن هذا النوع من الإنفاق ، وبهذه الكيفية مشفوعاً بطلب الدعاء من الرسول تحقق لهم الغاية التي يقصدونها :
(أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ)
وهذه أول بشارة لهم في تحقيق ما يريدون الوصول إليه فقد أخبرتهم الآية الكريمة بأن هذه النفقة قربة لهم ، وقد قبل الله قربهم.
أما البشارة الثانية فقد جاءت مترتبة على هذا الاخبار بحصول التقرب منه سبحانه :
(سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ)
ورحمته هنا مطلقة لم تقيد بأنها في الدنيا فقط ، أو في الآخرة فقط ، بل هي شاملة لهما معاً ولا ينقص من عطائه شيء ويدل على ذلك قوله سبحانه في آخر الآية :
ص: 88
( إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
فما يعود إلى ذنوبهم فهو غفور.
وما يعود إلى جزائهم فهو رحيم.
يشملهم بكل جزاء في الدنيا بأن يبارك في أعمالهم.
وفي الآخرة بأدخالهم الجنة التي أعدها لعباده المؤمنين.
وعندما تتطور العلاقة بين العبد وربه فتخرج عن نطاق تقرب العبد إلى ربه لنيل جزاء أو لغفران ذنب بل لتصل إلى مرحلة الحب والفناء في سبيل الطرف الآخر نجد القرآن الكريم يتحدث باعتزاز لينوه عن هذا النوع من المحبين ويكشف عن نفسياتهم العالية ، والتي تتجه إلى خالقها اتجاه الحبيب يحن إلى لقيا حبيبه انصهروا في ذاته المقدسة فأخذوا يقدمون النفوس للتقرب لساحته المقدسة لا المال والطعام فقط فهم يحبونه ويحنون إليه.
يقول سبحانه عن هؤلاء :
(إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ) (1).
والملاحظ على هذه الآيات الكريمة انها مهدت للحديث عن هذه الشخصيات المؤمنة بأن ذكرت جزاءهم في الآخرة وان مكانهم الجنة.
وقد ذكر المفسرون أن هذه الآيات نزلت في آل بيت محمد صلی الله علیه و آله علي وفاطمة والحسن والحسين علیهم السلام ، حيث روي عن ابن عباس ان الحسن والحسين علیهم السلام مرضاً فعادهما رسول الله صلی الله علیه و آله في اناس معه ، فقالوا : يا ابا الحسن لو نذرت على
ص: 89
ولدِك فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن عافاهما الله تعالى أن يصوموا ثالثة أيام فشفيا وما معهم شيء فاستقرض علي علیه السلام ثلاثة اصوع من شعير فطحنتة فاطمة علیه السلام صاعاً وخبزته خمسة أقراص على عددهم ووضعوها بين أنديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال :
« السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين اطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء فأصبحوا صائمين فلما أمسكوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه وجاءهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخذ علي علیه السلام بيد الحسن والحسين علیهم السلام ، ودخلوا على الرسول صلی الله علیه و آله فلما أبصرهم ، وهو يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال :
ما أشد ما أرى بكم ، وقام فأنطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها ، وقد التصق بطنها بظهرها ، وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل جبرائيل بالسورة ، وقال خذها يا محمد هنأك الله في أهل بيتك فأقرئها السورة » (1).
وبين يدي هذه الآيات الكريمة والواقعة التي كانت السبب في نزولها نقف لنستفيد من نقاطها التالية دروساً قيّمة نكيف على ضوئها حياتنا لنسير على الخط الذي رسمه لنا هؤلاء القادة الابطال وبينوا الخطوط العريضة لنوعية العلاقة التي لابد من حصولها بين الإنسان وخالقة وبين الإنسان ومجتمعه.
( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ) :
هذا العلاقة الشفافة التي لا يشوبها رياء ، ولا يشوه منظرها من شيء من المقاصد والغايات الدنيوية كأنتطار جزاء من أحد ، ولا خوف من آخرين.
بل كل ما في البين هوحب الله والفناء في ذاته المقدسة ، وهو الغاية لهم في كل عمل يقدمون عيله في هذه الحياة.
واطعام الطعام على حبه صورة من صور هذه العلاقة الأكيدة بين الله ، وعباده المؤمنين.
ص: 90
(إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا) :
عباد الله المؤمنين بهذه النفسية العالية يواجهون الطبقات الضعيفة المحرومة.
انهم لا ينتطرون منهم جزاءً ولا يريدون منهم التملق والشكر على ما منحوه لهم ذلك لأن الفقير ليس طرفاً للحساب معهم بل حسابهم مع الله ، والفقير إنما هو المسرح الذي يعرضون عليه صور حبهم لله سبحانه سواء كانت تك الصورة لمسكين ، أو ليتيم ، أو لأسير ، أوغير ذلك من القضايا والمشاكل التي تحيط بالمجتمع ككل وبالأفراد على نحو الخصوصية الفردية.
مع الحادثة التي كانت السبب في نزول الآيات :
وعندما تتأمل الحادثة التي كانت السبب في نزول هذه الآيات بما اشتملت عليه من نقاط حساسة نقول بالإمكان أن نستفيد منها الدروس التالية :
يقول العائدون لأمير المؤمنين علیه السلام لو نذرت على ولدك نذراً ، ويمتثل الأب العطوف ، والأم الحانية تتبعهما جاريتهما فينذرون لله ان عافى الحسن ، والحسين صاموا لله ثلاثة أيام.
ومن هذا الامتثال تتجلى روعة التقديس لله ، والحب له إذ كان بأمكان الإمام أمير المؤمنين أن يتوجه إلى النبي محمد صلی الله علیه و آله فيطلب منه أن يرفع يده إلى السماء ليدعوا لشفاء ولديه ، ولا بد من الاستجابة لأن الله لا يرد دعوة نبيه ، ولا يخيبه فيها ، وتنتهي المشكلة بسلام.
ولكن الإمام لم يسلك هذا الطريق لأنه كان يتحين الفرص لأن يتوجه إلى الله عبر صلاته ، أو صيام ، أو جهاد ، أو عمل فيه خير ، وما شاكل.
إن الدعاء يسد عليه هذا الطريق ، ويضيع عليه هذا الفرصة لذلك امتثل ابن أبي طالب ، ونذر صوم الأيام الثلاثة ، وتبعه موكب الإيمان يتمثل بنذر سيدة النساء ،
ص: 91
وفضة جاريتها التي نشأت في هذا البيت الذي لا تسمع بين أروقته الا تلاوة القرآن الكريم ، أو الدعاء ، والتضرع إلى الله عز وجل.
علي علیه السلام ، وهو صهر الرسول ، وابن عمه والمقرب عنده ، والذاب عن الإسلام.
وفاطمة بنت الزعيم الروحي ، والعسكري للمسلمين.
والحسنان ريحانتا رسول الله صلی الله علیه و آله وولداه وحبه لهما أشهر من أن يتحدث عنه.
ومع كل هذا الخصوصيات نرى هذا البيت يخلوا من طعام يفطرون عليه مع ما عليه هذه العائلة من قلة العدد بحيث يضطر الإمام علیه السلام أن يستقرض ثلاثة أصوع من شعير ليكون قوتاً لهم في إفطارهم لصوم نذره لشفاء ريحانة رسول الله صلی الله علیه و آله .
ولم يحدثنا التاريخ ان الرسول الأعظم ، وهو القائد الأعلى للمسلمين والأب الروحي لهم ، وولي الأمر ، ومن بيده بيت المال المسلمين رعى هذا البيت من الجهة المالية بأكثر مما كان يرعى يه بقية البيوت.
ان فاطمة بنت محمد : صلی الله علیه و آله والذي كان يقبل يديها ويقول مفتخراً ليعلم الناس بمكانتها عنده ( فاطمة أم أبيها ) ، ويسلم عليها عند خروجه من المسجد ، وفي طريق عودته منه عنده كبقية نساء المسلمين.
وعلي : وهو الذي اتخذه أخاً عندما آخى بين المسلمين بعضهم مع البعض عنده من هذه الجهة كفرد من أفراد المسلمين من الجهة المالية.
والحسنان : ولطالما رأى المسلمون النبي صلی الله علیه و آله يطيل في سجوده لأن ، أحدهما جلس على ظهر جده فلا يريد أن ينحى لئلا ينزعج الطفل فيفسد عليه بسمته ، وفرحته.
هذا البيت الطاهر بهذه الأسرة الكريمة نراه خالياً من ثلاثة أصوع من الشعير يقتات بها أهله.
ص: 92
وهكذا تتجلى الأمانة علىالأموال ، والترفع عن مد اليد إلى أموال المسلمين وإن كان ذلك من مثل رسول الله صلی الله علیه و آله وهوالولي ، والمشرع الذي لا يقف في وجهه شيء.
ومن خلال هذا العمل تظهر عملية التكافل لتبرز بأجلى صورة عاطفية :
ففاطمة بنت النبي ، وزوجة أمير المؤمنين ، وأم الحسنين ، وسيدة نساء العالمين تتحمل المسؤلية بنفسها ، فتطحن الشعير ، وتخبزه ، وهي صائمة مع وجود خادمتها فضة في البيت.
هكذا فليكن العطف والنحو نحو الخدم ، والمساعدين ان الإسلام لا يريد من الفرد ان يفرض سيطرته على الأفراد بغض النظر عن شخصية هذا الفرد فالناس اكرمهم عند الله اتقاهم ، وهم كأسنان المشط لافضل لأبيضهم على أسودهم ، ولا العكس إلا بالتقوى.
وإنما أجاز أن يخدم بعضهم بعضاً بعنوان المساعدة ، ولقاء أجور يتقاضاها من يقدم الخدمة.
أما أن يكون ذلك سبباً لتسلط أحدهم على لآخر تسلطاً يشوبه الظلم والاستعلاء ، والتكبر فهذا ما لا يريده للمسلمين.
وحري بسيدات المجتمع وأمهات البيوت أن تكون هذه الحادثة هي المقياس للمعاملة مع الخدم والمساعدين ، وكل الطبقات الضعيفة المحرومة.
إن على ربة البيت أن تفكر أن الخادمة انسانة مثلها ، وليس على الله بعزيز ان يمكنها لتكون أم بيت مثلها ، ولكن لحكمة اقتضت هذا التفريق بينهما فتكون هي أم بيت وتلك خادمة.
ان التاريخ يحدثنا عن سيرة أهل البيت علیهم السلام مع خدمهم وجواريهم فيعطينا صوراً رقيقة لمعاملة حسنة تنسي الخادم ، أنه يخدم في البيت.
فهذا أمير المؤمنين علیه السلام تقول مصادر التاريخ عنه انه كان يشتري الثوبين له
ص: 93
ولغلامه قنبر ، ويخيره أولاً بانتقاء أحسنهما.
وفي صورة أخرى من صور العطف نرى الإمام زين العابدين علیه السلام في مشهد من المشاهد المألوفة في تلك الأيام تصب الجارية الماء على يده فيقع الأبريق على رأسه أو يده فيشجه ، وقبل أن يلتفت الإمام إلى الجارية تسارع الجارية والخوف قد أخذ مأخذه منها.
فتقول للإمام : والكاظمين الغيظ.
فيجيب الإمام : كظمت غيظي.
وتعقب الجارية قائلة : والعافين عن الناس.
فيقول الإمام : قد عفوت عنك.
وتطمع الجارية في المسامحة التي تشاهدها من الإمام فتقول :
« والله يحب المحسنين » :
فيبتسم الإمام في وجهها قائلاً : أذهبي فأنت حرة لوجه الله.
صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة ويا معدن الخلق ، والسماحة ، والكرم. بهذه المعاملة الطيبة تعاملون الطبقات الفقيرة كأنهم اخوان لا خدم فلا تشعرونهم بذلة الخدمة ، بل بعزة الإنسان الذي يتطوع لمساعدة أخيه.
يدخل رسول الله صلی الله علیه و آله على ابنته الصائمة التي أخذ الجوع منها مأخذه ، وبدلاً من أن يجدها تولول ، أو تثور في وجهه شاكية من انتقالها إلى مثل هذا البيت الذي لا تضم خباياه ثلاثة اصوع من شعير ، بدلاً من كل هذا ، وغيره يراها في محرابها تتجه إلى خالقها في خلوة حبيبه تقدسه ، وتمجده وتصلي له.
لقد فقدت فاطمة علیهاالسلام الغذاء الجسمي لأنها بذلك ضربت المثل الإعلى للمواساة ، ولكنها عوضت عنه بالغذاء الروحي لتسلم أمرها إلى الله الذي بذلوا كل
ص: 94
نفيس في سبيل التقرب إليه.
إن هذا البيت المقدس ليكون بجدارة ، واستحقاق موضع عناية الله ، ورعايته وتقديره ليُذهب عن أهله الرجس ، ويطهرهم تطهيراً.
ولتنال هذه الأسرة الصابرة المحتسبة جزاء حبهم لله وتعلقهم به أن يقول عنهم القرآن لكريم :
( فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا * مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا * وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا * وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا * وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا * عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا * وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا * عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا * إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً ) (1).
وبعد كل هذا الجزاء الوافي تلقوا من ربهم الوسام الروحي الذي يفترحون به على مرور الزمن حيث قال سبحانه يختم هذه المشاهد : ( وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا)(2).
وقبل أن نودع الآيات الكريمة بمشاهدها المثيرة وبما اشتملت عليه من عرض هذه الصور الجزائية نقول : ليس ذلك مختصاً بآل البيت علیهم السلام ليحرم منه غيرهم لا ، بل أن أهل البيت إنما نالوا ذلك لأنهم أظهر المصاديق لعباد الله المؤمنين المحبين له ، والمتفانين في ذاته المقدسة ، وقد جعل الله الباب مفتوحاً لكل فرد من الناس يرغب في إنشاء مثل هذه العلاقة معه فهو الغفور الرحيم ، وهو الذي يقبل التوبة من عباده ، وهو الذي يقول عبدي أوجدت صدراً أوسع مني فشكوتني إليه ؟.
ص: 95
لقد سبق أن بينا في أول البحث أن الإسلام قد أخذ بعين الاعتبار الاعتدال في الأمور كأساس للنظام الإجتماعي ، وبذلك يمكن التعديل وتسير الأمور على النحو الوسط.
وقد جعل من الآية الكريمة :
(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) (1).
مقياساً وضابطاً لتعديل الإنسان في حياته الإجتماعية. والآية الكريمة ، وان كان لسانها هو العطاء والبذل ، والمنع ، والشح ، ولكن - كما قلنا - آيات القرآن أحكام تشريعية لا تخص بمورد دون آخر ، ولا بوقت دون وقت إلا أن تقوم القرينة على الاختصاص ، ومع عدمها فالقضية تبقى عامة والحكم شامل وسار ، وقد اشتملت الآية الكريمة على مقاطع ثلاث ، ومن مجموعها تثبت القاعدة المذكورة.
1 - (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ) :
وهذا هو المقياس ، والضابط للإمتناع ، وعدم الاقدام ومسك اليد كما لو كانت يد الإنسان مشدودة إلى عنقه فلا يقدر على البذل ، والعطاء .
2 - (وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ) :
وهذه هي الصورة المعبرة لإنبساط اليد ، وعدم الادخار بحيث يبذل الإنسان يبقى فلا شيئاً له.
فلا هذا ولا ذاك لأن كلاً من هاتين الحالتين تؤدي بالإنسان إلى عدم الاعتدال ، وحينئذٍ :
3 - (فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) :
ملوماً في حالة الإمتناع حيث تلوكه الألسن وتتحدث عن بخله الناس فيلومونه على هذه الحالة.
ص: 96
ومحسوراً في حالة البسط ، والعطاء الكلي لأنه سينقطع عن كل أحد ، والناس كما يقول الشاعر :
والناس من يلق خيراً قائلون له *** لك البقا ولأم الخاسر البهل
وقد جاء عن الإمام الصادق علیه السلام في توضيح له لهذه الآية :
« أن أمسكت تقعد ملوماً مذموماً ، وان أسرفت بقيت منحسرا مغموماً » (1).
ومن هذا المنطلق والسير على ضوء هذه القاعدة الكبرى كأساس لحفظ التوازن والتعديل.
تأتي الآيات الكريمة لتضع الشرط الثاني للإنفاق فتقرر ضرورة الاعتدال فيه.
(وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) (2).
والآية جاءت في معرض الحديث عن عباد الرحمن حيث قال سبحانه فيما سبق هذه الآية :
(وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) (3).
وقال تعالى فيما بعد هذه الآية ، وهو يعدد صفات عباده الذين ارتضاهم لنفسه.
(وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) (4).
ص: 97
هؤلاء هم عباد الرحمن الذين تحدثت عنهم الآيات الكريمة بشيء من الاعتزاز.
سمتهم الاعتدال في كل اعمالهم مع ربهم ، ومع مجتمعهم ، وفي ليلهم ، وفي نهارهم.
أما مع ربهم حيث رأينا الآية تقول عنهم : انهم يبتون لربهم سجداً وقياماً.
يحنون إلى الليل كما تحن الطيور إلى أوكارها يقومون بين يدي الله خاشعين مصلين يسبحونه ويعظمونه سجداً وقياماً.
وربما كان منظرهم هذا وانهماكهم بالعبادة موجباً لأن يتخيل الإنسان أن هؤلاء رهباناً عباداً تركوا الدنيا وعزفت نفوسهم عن كل شيء ، واتجهوا إلى الله فأين الاعتدال في أوضاعهم ؟
وسرعان ما يتبدد هذا التصور عندما نراهم يطلبون من الله ، وهم في مثل هذا الحال قائلين :
(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) (1).
فهم في الوقت الذي يؤدون ما عليهم اتجاه خالقهم يريدون منه أن يهيء لهم أزواجاً ، ومن الأزواج ذرية طيبة تقر بذلك أعينهم فهم يجمعون بين الغذائين الروحي والجسدي.
وأما مع مجتمعهم فهم يتحسسون مشاكله ويعيشون آلام الطبقات الضعيفة ينفقون مما رزقهم الله ولا يضنون بالمال عليهم ، ولكن بشكل معتدل يرضون به ربهم ويحفظون به على رصيدهم.
(وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) (2).
وهذا هو الخط المعتدل في الصرف والانفاق «لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا» حفاظاً
ص: 98
على المال ورعاية له.
(لَمْ يُسْرِفُوا) :
لأن المال الذي أعطاه الله لهم فيه حق لآخرين من الأهل والعيال والورثة فلا بد من رعايتهم لئلا يتركهم من يعول بهم يتسولون.
(وَلَمْ يَقْتُرُوا) :
لأن في ذلك جناية على المال وكفراناً لنعمة الله على من ملكه ... ذلك لأن الله رزق العبد لينتفع به وفي الوقت نفسه لينتفع به الآخرون من أفراد المجتمع لا ليحبسه ويحجر عليه.
وإذاً فلا بد من الاعتدال في الإنفاق والمحافظة على النقطة ، والوسط بين الحالتين ، ولذلك أوصت الآية الكريمة أن يتحلى الإنسان في هذه الحياة بما فيه إنفاقه بمضمون الآية عندما تقرر قوله تعالى :
(وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) :
والقوام الوسط العدل بين الافراط والتفريط وبين الاسراف والشح وبين الاسراع والتباطؤ.
وبعد أن تعدد الآيات صفات هؤلاء المؤمنين المعتدلين تبشرهم بجزاء هذه الصفات ، وهذا الاعتدال الطبيعي في مسيرتهم الحياتية.
( أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا * خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) (1).
وكان من هؤلاء الذين ذكرت جزاءهم الآية الكريمة : المؤمنون المعتدلون في الانفاق - موضوع بحثنا - فقد جزاهم ربهم الغرفة - الجنة - تتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام تكريماً لهم خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً.
ص: 99
وفي وصايا أخرى تتعلق بموضوع بحثنا نرى القرآن الكريم يحذر المنفقين في أن يبسطوا أيديهم في إنفاقهم بما يضر بحالهم ويؤثر على الوضع المالي للمنفقين قال عز وجل :
(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (1).
أما سبيل الله : هو كل طريق شرعه الله تعالى لعباده ، ويدخل فيه الجهاد والحج ، وعمارة القناطر ، والمساجد ، ومعاونة المساكين ، والأيتام ، وغير ذلك ، بل وكل ما أمر الله به من أبواب الخير ، والبر ، وحينئذٍ فيكون السبيل هو الطريق.
والآية تسير على نفس الخط الذي رسمته الآيات المتقدمة من ضرورة الاعتدال في الانفاق وعدم الإسراف فيه لأن الاسراف وانفاق المال يؤدي إلى التهلكة وهي الضياع إذ أن أصل الهلاك هو الضياع والهالك الفقير بمضيعة (2).
وإنما يكون بمضيعة لأنه كان غنياً موسراً فأصبح فقيراً معدماً ، فهو بمضيعة فقد ما يقوم مغاشه يقول الإمام أبو عبد الله الصادق علیه السلام :
لو أن رجلاً انفق ما في يده في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق لقوله سبحانه : (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (3).
وعندما يحذر القرآن المنفقين عن إلقاء أنفسهم في التهلكة عند الإنفاق بغير اعتدال فإنه في نفس الوقت يوجههم إلى السير المنظم في الطريق المستقيم كحد وسط بين الاسراف والتقتير لذلك ختمت الآية الموضوع بقوله عز وجل :
(وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (4).
وقد فسر قوله ( المحسنين ) بالمقتصدين.
ص: 100
والاقتصاد هو الاعتدال في الصرف (1).
ولا يقتصر الايصاء من القرآن على الاعتدال في الإنفاق من حيث القلة والكثرة ، بل هناك جهة أخرى لابد من رعايتها ، وهي عدم التبذير فقد قال سبحانه :
( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) (2).
قال في المجمع التبذير التفريق بالاسراف ، وأصله أن يفرق البذر إلا أنه يختص بما يكون على سبيل الافساد. وما كان على سبيل الإصلاح لا يسمى تبذيراً وان كثر (3).
وهذه النقطة لابد من ملاحظتها ورعايتها لأن النتائج المترتبة على التبذير أخطر من النتائج التي تترتب على الاسراف في الانفاق والذي عبر القرآن عنه بالوقوع بالتهلكة ، أو في الآية المتقدمة أن المسرف يقعد ملوماً محسوراً.
وذلك لأن الاسراف لا يخلف إلا الضرر على المنفق ، ومن يرثه حيث صرف المال كله وجلس معدماً محسوراً ، أما المبذر فإنه لا ينفق المال في حقه.
« وعن مجاهد لو انفق المال في باطل كان مبذراً »(4).
وفرق كثير بين إنفاقه كله وعلى الأخص لو كان في سبيل الله وبين إنفاقه في الباطل.
ولذا رأينا الآية الكريمة قالت عن المبذرين إنهم.
(كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) :
ص: 101
لأنهم لا ينفقون مالهم في الحق ، وفي طريق الخير ، ولذا كانوا إخواناً للشياطين وليتبوأ مقعده في النار من كان اخاً للشيطان وقريناً له.
أما المسرفون : فلم يرد فيهم مثل ذلك بل أقصى ما جاء فيه ان يدخل الضرر على نفسه فيقعد ملوماً محسوراً.
الإنفاق من الطيب :
الإنفاق إحسان من المعطي إلى الفقير وتعاطف بين افراد المجتمع والله من وراء القصد يرعى هذه الأريحية ويبارك هذه الصفقات الخيرة.
وإذا كان الأمر كذلك فمن الأفضل أن يقدم المحسن أطيب ما عنده إلى الفقير.
وليس من اللائق أن يعطيه من الرديء ليتخلص منه.
الرديء الذي إذا قبضه الفقير قبضه وهو يغمض عينيه ويطرق برأسه.
والرديء الذي لو كان المعطي يريد بيعه لما اشتراه منه أحد إلا بأقل من ثمنه.
هذا الرديء هل يصلح ان يقدم هدية إلى الله وتقرباً لنيل مرضاته ؟
وهل بهذا النوع يرجو المعطي ان تكون صفقته مع الله تجارة لن تبور ؟
وهل أن هذا الرديء هو الذي يأمل المعطي أن يأخذه لله منه قبل أن يأخذه الفقير ؟
انها تساؤلات لابد للمنفق ان يجيب عليها أو يتأملها قبل أن يقدم النوع الرديء من المال إلى الفقير.
ولذلك ترى الآية الكريمة تحدد أبعاد نوعية ما يعطيه المحسن إلى المحتاجين.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
ص: 102
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) (1).
وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن قوماً من الانصار في المدينة كانوا يأتون بالحشف من التمر فيدخلونه في تمر الصدقة الجيد فنزلت الآية تنهاهم عن ذلك.
وقد تعرضت كتبت التفسير لهذه الرواية بشكل من التطويل ، والمهم هو ان هذه الرواية تعطينا ان الانفاق بعدما كان تضميداً لجراح الفقير ، ومواساة له في محنته ، فإن الخُلق الرفيع يقتضي أن تكون هذه المواساة على النحو الأحسن لتثمر وتؤثر أثرها الطيب في نفوس الضعفاء والمحرومين ليشعر كل فرد منهم بالعطف والمشاركة لهم في الطيب من العيش لا للتخلص من هذا الذي قدم لهم.
ان شعور الفقير بأن ما دفعه إليه المحسن من النوع الرديء إنما كان للتخلص من رداءته ليترك في نفسه الأثر السيء أزاء المنفق الذي بدل المفاهيم الخيرة.
على انه - كما قلنا - في البين طرف ثالث دخل في هذه الصفقة وهو - الله سبحانه - وهو يصرح بأنه عز وجل غني عن صدقاتهم وإنما يريد الخير لهم .
(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) :
فهو غني عما تقدمونه للفقير تقرباً له وحصولاً لمرضاته ، ولكنه - في نفس الوقت - حميد يشكركم على عطائكم لو أعطيتم.
ولكن هذا الشكر انما يكون لو أعطيتم ، ولو كان ما قدمتوه لوجهه من طيب ما تقدمونه.
ثم يعقب القرآن الكريم لينبه المنفقين بأن هذه الحالة التي تساوركم في دفع الرديء إنما تنشأ من حرصكم على المال وحبكم في المحافظة عليه ولذلك تأبى نفوسكم أن تقدموا الشيء الجيد لئلا تذهب خيار أموالكم فتصبحون معدمين فقراء،
ص: 103
وهذه وساوس شيطانية لا أساس لها فإن من قدم لله فعليه جزاؤه ، ومن كان جزاؤه على الله فكيف يخشى الفقر ؟.
وتدلل الآيات على ذلك بإجراء مقارنة بين وعدين أحدهما صادر من الشيطان والآخر من الله سبحانه وكم بين الوعدين من الفرق ..
(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (1).
(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ) :
الشيطان يوحي بأن اعطاء المال الجيد ، أو مطلق بركم وإنفاقكم في سبيل الله يؤدي بكم بالنتيجة إلى الفقر.
(وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) :
أي المعاصي والرذائل ، وقيل بالإنفاق من الرديء وسماه فحشاء لأن فيه معصية الله حيث أنه لم يخرج مما عينه الله له فإن الغني إذا ترك الإنفاق على ذوي الحاجات من أقرابه وجيرانه ، وبقية أفراد المجتمع أدى ذلك إلى التقاطع ، وكل تركٍ لحقوق الله هو من الفحشاء.
وبذلك تنتهي وعود الشيطان ومغرياته.
(وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) :
وعدان من الشيطان سبقا.
وها هما وعدان من الله تقررهما الآية الكريمة لمن ينفق عن طيب نفس ويخرج من جيد ماله لينعش به ذوي الدخل المحدود.
أحدهما : أخروي.
والآخر : دنيوي.
ص: 104
أما الأخروي : فهو الوعد بالمغفرة للذنوب وبذلك ينال المنفق الجنة.
وأما الدنيوي : فهو الفضل أي ويعدكم أن يخلف عليكم ما أنفقتموه ويتفضل عليكم بالزيادة.
وقد سبق لنا أن نقلنا الآيات الكريمة التي وعد الله فيها المنفقين بمضاعفة الرزق وأن ما ينفقونه بنسبة كل واحد في قبالة سبعمائة.
وقد جاء عن ابن عباس انه قال إثنان من الله وإثنان من الشيطان فاللذان من الله المغفرة على المعاصي ، والفضل في الرزق والذان من الشيطان الوعد بالفقر ، والأمر بالفحشاء (1).
ولنقارن بين الوعدين :
الله يعد بالفضل والزيادة.
والشيطان يعد بالفقر.
والله يعد بالمغفرة رحمة منه.
والشيطان يأمر بالفحشاء والرذيلة.
وليقف الإنسان ويخير نفسه بأي من هذين الوعدين يأخذ ؟.
الوعد المشرق من الله الذي يفتح أمام المنفق النوافذ العريضة ليطل منها على مغفرة الله وآيات فضله.
والوعد القاتم الكئيب من الشيطان ، الذي يغلق في وجه المنفق كل الابواب التي يرجوا أن يدخل منها إلى ساحة الله المقدسة لينعم بآلائه والطافه.
(وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) :
وتختم الآية الكريمة المقارنة بين الوعدين : وعد الله ووعد الشيطان بهذا العتاب الرقيق ، وان الله واسع ، فلماذا الخوف من الفقر وتصديق الشيطان بما يخوفهم به ، والله
ص: 105
واسع في عطيته ، وإنه اذا وعد وفى ؟ وحتى اذا لم يعد فهو الرازق ، وهو الرحيم وهو الودود وإذا صدر منه الوعد فإنما ليطمئن الإنسان بأنه سيلقى الجزاء ، بأحسن وبأكثر مما يتصوره المنفق فلا حاجة لوعد الله بعد أن علم الإنسان أن مصدر العطاء هو الله سبحانه وان لطفه ورحمته لا يختصان بفئة دون فئة وقد جاء في الاخبار بأن رحمة الله يطمع فيها يوم القيامة حتى أبليس وهو أبغض الخلق إلى الله عز وجل.
وأخيراً فإنه مضافاً إلى سعة عطاء الله فإنه :
(عَلِيمٌ) :
عليم بكل شيء ، ولا تخفى عليه خافية ، ومن ذلك ما يدفعه الإنسان ويقدمه في سبيله وطلباً لجلب مرضاته ، أو للرياء والسمعة والتقرب إلى الناس.
وعليم بمن يدفع الرديء عن قلة يد وعدم وجود أحسن منه ، أو للتخلص منه مع وجود الأحسن منه.
ومن الإنفاق من الطيب ينتقل القرآن الكريم إلى توجيه جديد يوجه به المنفقين إلى مرحلة يربط فيها بين المنفقين والمحتاجين بشكل أكد مما سبق حيث يجعل من الآيتين شخصاً واحداً على نحو يفكر الغني بالفقير كما لو يفكر بنفسه فيختار له ما يختاره لها ويجنبه مما لا يرغب فيه يقول سبحانه :
(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (1).
البر هو فعل الخير ، أو التوسع في فعل الخير ، ومن خلال هذه الآية تتجلى روعة التوجيه حيث أغلقت في وجه المنفق طريق الوصول لينهل منها إلا إذا كان شعوره بحاجة أخيه المسلم كشعوره بنفسه وما يعاف منه لا يريده له ، وما رغب فيه يريد تماماً كما يقول الحديث : « حب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك »(2).
ص: 106
وهذه هي الوحدة التي تجعل من أفراد المجتمع صفاً واحداً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ، وبهذا النوع من الانصهار بين الطرفين المنفق والفقير تسود روح التعاون بينهما فينظر الغني إلى الفقير نظرة الأخ إلى أخيه فيحب له ما يحبه لنفسه ، وكذلك الفقير ينظر إلى الغني نظر المنعم إليه فيتربص الفرصة ليرد الجميل إليه.
« وقد روي عن الطفيل قال إن أمير المؤمنين علیه السلام اشترى فأعجبه فتصدق به وقال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة ، ومن أحب شيئاً فجعله لله. قال الله تعالى يوم القيامة قد كان العباد يكافؤن فيما بينهم بالمعروف وأنا أكافيك اليوم بالجنة » (1).
وقد تصدق الإمام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام بالسكر على الفقير فقيل له :
« أتتصدق بالسكر ؟ قال : نعم إنه ليس أحب إلي منه وأنا أحبُ أن أتصدق بأحب الأشياء إلي » (2).
وفي نطاق هذا الشرط نرى القرآن الكريم ذكر آيات ثلاثة متعاقبة وقد بين فيها أن الإنفاق إنما يكون مرغوباً فيه ومرضياً له سبحانه لو لم يصاحبه منّ على الفقير ، ولا أذى يلحقه من المعطي.
وتبدأ الآيات بقوله تعالى :
(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (3).
ص: 107
ويقول جلت عظمته :
(قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) (1).
ويختم القرآن آياته في خصوص هذا الشرط بقوله عز وجل :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (2).
وعندما نلاحظ هذه الآيات الثلاث نراها تشترك في بيان معنى واحد اتفقت عليه بينما انفردت كل آية ببيان معنى اختصت به.
أما ما أتفقت عليه الآيات فأنها بمجموعها بينت أن الإنفاق إنما يكون مرضياً لله تعالى ويتقبله ويضاعف عليه لو كان المنفق يقدم عطاء غير مقرون بالمن والأذى.
أما المن بالعطاء : فهو توبيخ المعطى له أو تحميله بما يستلزم المشقة في قبال ما ينفقه.
إن القرآن الكريم بهذا الاسلوب من العطاء يريد من المنفق أن يكون :
اليد الحانية على الفقير ، والابتسامة المشرقة التي تزيل ما بقلب هذا المحروم من الكآبة والحزن.
والوجه المشرق وهو يناول سائله ما تجود به نفسه من خير.
فبهذه الصفات ، وبهذا الخلق الرفيع يكون الإنفاق مثمراً ، ومؤثراً أثره الحسن في نفس السائل.
ولكن لو انقلب الأمر وتبدلت هذه الابتسامة إلى عبوس وتقطيب ، أو تطور الأمر فأخذ المعطي يوبخ السائل ويزجره فإن هذا العطاء لا يحقق أثره المطلوب ولذلك لا يكون مرغوباً فيه.
ص: 108
ومعاً لنستعرض الآيات الكريمة وما جاء بمضمونها من الأخبار.
الآية الاولى : وفيها يقول سبحانه وتعالى :
(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (1).
لقد حددت الآية الكريمة الإنفاق الذي يثمر الثمر الطيب فينال به المنفق جزاءه في الدارين الدنيوي والاخروي ، فرسمت أبعاده وقيدته بأن لا يكون مشفوعاً بصورة تترك في النفس أثرها السيء وبذلك ينقلب الإحسان إلى الإساءة ، والخير إلى الشر ، بل لابد أن يكون الإنفاق رفعاً لمعنويات السائل أو المحتاج وجبراً لخاطره المكسور ليفهم أن العملية إنما هي تعاون بين أفراد الأسرة الواحدة لا أنها اعتداد وافتخار وعلو واستكبار للبعض على الآخرين.
وقد ضربت هذه الآية مثلين للصور التي لا يرغب الإسلام للإنفاق والعطاء :
الأول : عدم المن.
الثاني : عدم الأذى.
وقد بين بعض اللغويين المراد من المن هنا الذي قيل عنه بأنه عدم الاعتداد من المعطي فمثل له :
بأنه يجابه المنفق المحتاج بحالة تدل على تكبره واستعلائه وتفاخره بما يقدمه ، أو يوجه إليه كلمات خشنة تحطم معنوياته فيقول له - وعلى سبيل المثال - ألم أعطك ؟ ألم أحسن إليك ؟.
أو قوله : لولا عطيتي لكانت حالك كذا ومن هذا القبيل بقية الالفاظ التي تجرح عواطفه.
أما عدم الأذى : فمثلوا له بأن يقول المنفق للفقير أراحني الله منك أو من إبتلاني بك ؟ ، أو ليتني لم أتعرف عليك ، أو يتعدى مرحلة التوبيخ بالكلام إلى مرحلة العمل
ص: 109
فيطلب من السائل اعمالاً تسبب له التعب والمشقة لا هذا ولا ذاك بل عطاء مشفوع بلطف ورحمة ليشعر المحتاج بأنه لجأ إلى من يساعده ويقف إلى جانبه في محنته.
يقول النبي صلی الله علیه و آله كما عن أبي ذر الغفاري :
« ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل المنافق الذي لا يعطي شيئاً إلا بمنته والمسبل إزاره والمنفق سلعته باليمين الفاجرة » (1).
وفي خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله :
« أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة عاق ومنان ومكذب بالقدر ومدمن خمر » (2).
وفي حديث ثالث نرى النقمة تشتد على المنان فيقول النبي محمد صلی الله علیه و آله فيه :
« حرمت الجنة على المنان » (3) أو
« لا يدخل الجنة منان بالفعال للخير إذا عمله »(4).
ومن مجموع هذه الاخبار وغيرها نستفيد أن هذا الصنف من الناس نتيجة منّه بعطائه مبغوض لله سبحانه ، وغير مرغوب فيه وفي عطيته ويكفيه ذلاً أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة أو لا يكمله ، وأخيراً لا يدخله الجنة.
بهذا البيان تشترك الآية الكريمة مع الآيتين الأخريين ، ولكنها تنفرد عنهما بأنها تضمنت بيان أن الذين ينفقون أموالهم خالصة طيبة بدون منٍ ولا أذى :
(لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) :
ولكن الآية لم تحدد الأجر بأنه في الدنيا أو الآخرة ، بل كانت مطلقة من هذه الجهة ليشمل لطف الله المنفق فيمنحه الأجرين معاً ، واضاف بعد ذلك بأنها تبشرهم بقوله تعالى :
(وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) :
ص: 110
ولماذا يحزنون ؟
وقد وعدهم الله بأنهم سيجازون على ما صنعوا بما لم يحدده الله لهم ، ومن أكرم من الله ؟.
أما الآية الثانية : فقد قال سبحانه فيها :
(قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) (1).
وحيث كان الغرض من عملية الإنفاق هو النفع المادي والمعنوي للمحتاجين.
المادي : بأيصال المال أو الأعيان غير المال إليه.
والمعنوي : بإعطائه ما يشعره بالعطف واللطف والمواساة في محنته بما يحفظ له كرامته ... نرى هذه الآية الثانية تعقب هذا النوع من الناس الذين يتبعون ما أنفقوه بالمّن والأذى بهذا العتاب الرقيق فتوجههم إلى شكل آخر من أشكال اللطف مع هؤلاء المحرومين إذا هم لم يرغبوا بالعطاء من غير منٍ ولا أذىً.
ولماذا الأذى إلى الفقير ؟.
والمال متاع هذه الحياة الدنيا ، وليس له منه إلا ما يشبع بطنه وإذا أراد أن لا يعطي فليرد السائل بأدب وحشمة وبالكلمة الطيبة تحفظ بها كرامة السائل وهيبة المعطي - وعلى سبيل المثال - ليقول له وهو يرده :
وسع الله عليك من رزقه ، أو كان الله في عونك وما شاكل من هذا النوع من الكلام الذي يفهم به السائل بأنه لا يرغب في العطاء ، ولكن بشكل محتشم ومتزن وهاديء ، وهذا هو المراد من القول الميسور في آية أخرى جاءت تؤكد هذا المعنى في قوله :
( وإمّا تُعرضَنَّ عنهم ابتغاءَ رحمةٍ من ربّكَ ترجوهَا فقل لهُم قولاً ميسوراً )(2).
ص: 111
وقد روي أن النبي صلی الله علیه و آله بعد نزول هذه الآية ، ولم يكن عنده ما يعطي ، أو كان عنده ، ولكن كان يقصد تعليم الآخرين لأدب الرد يقول للسائل : ( رزقنا الله وإياك من فضله ) (1).
ومع الآية في عرضها التفصيلي فيما انفردت به من بيان ما يقوم به المنفق لو لم يرغب في الإنفاق ورد السائل بأدب.
تقول الآية الكريمة :
(قَوْلٌ مَعْرُوفٌ) :
والقول المعروف أدب رفيع تتوخى الآية أن يتجلى به المعطي ليُحسم الموقف بين الطرفين ، ولئلا يتطور إلى نزاع وخشونة ، وعلى فرض حصول مثل ذلك فإن الإية الكريمة تتجه إلى المعطي لتطلب منه أن يحسم هذا النزاع فيما لو صدر من السائل ما لا يرضى به من الالحاح ، أو التطاول في الكلام ، أو المطالبة في غير الوقت المناسب مما يعتبر جرحاً لعواطف المنفق وتحدياً له فإن الآية تريد منه أن يتجلى بالصبر ويغض عن كل ذلك ، ولا يعقب عليه ، وهذا هو المراد من الفقرة الثانية في قوله تعالى :
(وَمَغْفِرَةٌ) :
وتكون حصيلة الآية الكريمة عند عدم العطاء بتوجيه المعطي إلى القول :
بالمعروف لو لم يصدر من السائل تعقيب.
أو المغفرة : فيما لو صدر منه ما يسيء إلى المنفق.
وبتعبير أدق فإن الآية الكريمة تريد من المنفق أن يواجه السائل بأحد الطرق الآتية :
1 - العطاء ، وما يصاحبه من بشاشة وإنطلاق.
2 - القول المعروف لو لم يحصل العطاء.
ص: 112
3 - ضبط الأعصاب والأغضاء عن فعل السائل لو صدر منه ما يسيء إليه نتيجة عدم اعطائه.
ذلك لأن هذا السائل ربما كان صادقاً في مسألته ، وقد ضاقت الدنيا فلم يجد ملجأ يفر إليه غير التوجه إلى هذا المنفق ، وإذا كان هذا الحال السائل فليتحمل المسؤل منه ، وليرده بأدب ، أو ليغفر إساءته له وهذا خير من الصدقة مع المن والأذى فإن الأسلوب الجاف يزيد في تعقيد هذا المحروم وتهييج كوامن آلامه.
أما لماذا يكون هذا النحو من الأسلوب الهادئ سواءً بالقول المعروف أو المغفرة خير من هذه الصدقة مع المنّ والأذى فذلك لأن صاحب هذه الصدقة بهذا النحو من الأذى والمنّ لا يحصل على عين ماله في دنياه ولا على ثوابه في عقابه ، والقول بالمعروف والمغفرة عند الاساءة طاعتان يستحق الثواب عليهما.
وأما الفقرة الثالثة من الآية فقد قالت :
(وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) :
وقبل أن تختم الآية هذا العتاب تهدد المنفقين من طرف خفي بأن الله غني عن صدقة المنفق إذا شفعت المن والاذى فإن الله لا يريد من المنفق هذا النوع من المعروف الضحل لأنه ليس بعاجز أن ينفع الفقير بما يغنيه - كما سبق أن أوضحنا ذلك - ولكن المصالح تقتضي هذا النوع من التوزيع في الارزاق فهو غني عن صدقات المنفقين - ولكنه - في الوقت نفسه - يعطيم من فضله - ويأمرهم بالعطاء فيتخلفون عن ذلك أو يستجيبون ولكن بشكل من التأفف والضجر والمنّ على الفقير أو إيصال الأذى إليه.
كل ذلك يحلم سبحانه عنه ولا يعاجل هؤلاء المنفقين بالتعقيب ، بل يترك ذلك ليوم تشخص فيه الابصار.
ولكن إذا أخفقت هذه التوجيهات فلم تؤثر في سلوكية بعض المنفقين المتعنتين من تعديل مسيرة الانفاق بجعلها على النحو المهذب كما شرحته الآيتان الأولى
ص: 113
والثانية ، فإن القرآن الكريم يختم البحث بمكاشفة هؤلاء المعقدين ليواجههم بالحقيقة التالية من خلال قوله عز وجل.
في الآية الثالثة :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)(1).
وهكذا يعلن القرآن الكريم ليقول بالحرف الواحد.
(لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) :
والقصد من البطلان هنا هو أن مثل هذا العمل لا فائدة فيه لأن المنفق لا يستحق عليه ثوباً.
ويفهم هذا من تشبيه الآية الكريمة عمل المنفق الذي يتبع انفاقه بالمنِّ والأذى بأحد هذين العملين.
الأول : (كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) .
الثاني : (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا) .
ومع التمثيل الأول : (كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ) .
وحينئذ يكون حال المنفق حال من يرائي في عمله ليوجه الأنظار إليه ليحمد على ما يفعل ، وبذلك يحبط عمله.
وقد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله انه قال :
« إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ يسمع أهل الجمع اين الذين كانوا يعبدون الناس ؟ قوموا خذوا أجوركم ممن عملتم له فإني لا أقبل عملاً خالطه شيء من الدنيا وأهلها »(2).
ص: 114
(وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) :
وهذه صفة أخرى للمشبه به أي المنفق الذي ينفق بالمنّ والأذى عمله كعمل المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ... إذ لو كان المرائي يؤمن بالله واليوم الآخر لقصد في فعله وجه الله ولأختار الطرق التي بينها سبحانه وأراد من عباده السير عليها.
وقد جاء عن الإمام الصادق علیه السلام أنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : « من أسدى إلى مؤمن معروفاً ثم آذاه بالكلام ، أو منّ عليه فقد أبطل الله صدقته ، ثم ضرب فيه مثلاً فقال : كالذي ينفق ماله رئاء الناس - إلى قوله - والله لا يهدي القوم الكافرين » (1).
وقد أكدت الآية الكريمة على تعرية عمل المنفق الذي لا يرد الفقير ولكن يشفع عمله بالمنّ والأذى بتشبيه ذلك العمل بمنظر مألوف للناس في نطاق مشاهدهم العادية فقال تعالى :
(فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا) .
وصفوان : هو الحجر الأملس.
والوابل : هو المطر العظيم.
والصلد : المتجمد.
وقد شبه الله سبحانه عمل المنفق المرائي وهو يرجوا الثواب من عمله بهذا المشهد الذي لا يثمر شيئاً وهو مشهد الحجر الصلد الذي يكون عليه مقدار من التراب فينزل عليه المطر فيزيل ذلك التراب ويبقى الحجر الصلد لا يثمر شيئاً لعدم وجود تراب ليزرع فيه.
وبالأخير لا ثمر في هذين المشهدين.
عمل المرائي المنان.
وعمل من يزرع في مثل هذا الحجر الصلد.
كله هواء في شبك كما يقول المثل المعروف.
ص: 115
من شروط الإنفاق : ينتقل القرآن الكريم إلى أدب العطاء ، فنجد فيما يخص الموضوع آية واحدة توجه المنفق إلى كيفية العطاء بما يضمن له ثواباً أكثر فيما لو كانت عطيته على النحو الذي بينته الآية الكريمة في قوله تعالى :
(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (1).
وطبيعي أن يكون العطاء إلى المحتاج سراً أفضل من الاعلان به ... وذلك لأن صدقة السر تحقق أهدافاً ثلاثة بينما صدقة العلن لا تحقق إلا هذفاً وحداً.
أما الأهداف التي تحققها صدقة السر فهي :
أولاً : عطاء من المنفق إلى الفقير وإصّال خيرٍ له ، به يُسدُّ حاجته.
ثانياً : ان صدقة السر بعيدة عن الرياء إذ الرياء إنما يتحقق مع الإظهار والإعلان بالشيء ، أما مع الإخفاء فلا معنى للرياء لعدم إطلاع أحد على العطاء غير الفقير ، وبذلك تسلم عملية الإنفاق من الشوائب غير المحبوبة.
ثالثاً : إن صدقة السر تحفظ الفقير كرامته ، ولا تجرح شعوره إذ الكثير من الناس لا يقبلون أن تهدر كرامتهم ولو كان ذلك من طريق الإحسان إليهم ، فلا يريدون أن يعرف عنهم أنهم بحاجة وعَوَز ولذلك قالت عنهم الآية الكريمة :
ص: 116
(يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) (1).
كل هذه المميزات لا نجدها متوفرة في صدقة العلن لاحتمال أن يصاحبها الرياء - وفي الوقت نفسه - قد يتضايق منها الفقير فيما لو كان غير راغبٍ بأن يفهم الناس عنه بأنه محتاج وفقير - كما قلنا -.
هذا هو الفارق بين الصدقتين : صدقةِ السر ، وصدقةِ العلن.
مضافاً إلى أنه قد وردت أخبار كثيرة في فضل صدقة السر ، وأنها تحقق أهدافاً عديدةً :
منها : أنها تطفئ غضب الرب ، وتطفيء الخطيئة ، وتنفي الفقر وتزيد في العمر ، وتدفع سبعين ميتةَ سوء ، وتدفع سبعين باباً من البلاء.
وقد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله قوله : « سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله - إلى أن قال - : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله » (2).
وهذا الرجل بهذه النفسية الطيبة يخفي عطاءه حتى لا يعلم به أحد ، وهو واحد من السبعة الذين يظلهم الله يومن القيامة ، وعطاؤه يطفئ غضب الرب - وفي الوقت نفسه - محبوب لله.
هذا الرجل لماذا نال هذه الدرجات ؟
ويأتي الجواب واضحاً بأنه حصل على كل ذلك لأنه ستر أخاه المؤمن ، وحفظ له كرامته ، ولم يجرح عواطفه.
ومن الواضح أن الله يحب الساترين ، ويمنحهم الثواب ويجزل لهم العطاء.
وقد سار أئمة أهل البيت علیهم السلام على هذا النهج ، فكانوا يخفون عطاءهم فإذا ضرب الليل باجنحته ، ولف المدينة بظلامه الدامس قاموا ليتفقدوا البؤساء ،
ص: 117
والمحتاجين يطرقون أبواب الفقراء ليوصلوا لهم الطعام ، والكساء ، والنقود.
وسنتطرق إلى هذا الموضوع بشكل أوسع في فصل قادم.
« وقد اختلفوا في الصدقة التي يكون إخفاؤها أفضل فهل هي الصدقة الواجبة أم المستحبة ؟
فقيل : صدقة التطوع إخفاءها أفضل لأن إخفاءها يبعدها عن الرياء ، وأما المفروضة فلا يدخلها الرياء ، بل على العكس لو أخفاها الإنسان للحقته تهمة منع الحق المفروض فإظهارها أفضل من التستر بها ».
يقول الإمام أبو عبد الله الصادق علیه السلام موضحاً هذا المعنى :
« الزكاة المفروضة تخرج علانية ، وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعه سراً أفضل ، وقيل الأخفاء في كل صدقة من زكاة ، وغيرها أفضل » (1).
أما إذا رجعنا إلى القرآن الكريم فإن الآية الكريمة مطلقة لا تفصل بين الصدقتين الواجبة والتطوعية بل تقول :
(وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) .
ونظراً لإطلاق هذه الآية والتفصيلات في الأخبار كما عرفت فقد خرج الفقهاء بالنتيجة التالية :
وهي أن مطلق الصدقة زكاة كانت أو غيرها من الصدقات المستحبة إخفاؤها أفضل من اعلانها لما بيناه من وجود الفائدة في الإخفاء.
ولكن إذا كان الإخفاء موجباً لاتهام الإنسان بعدم إخراج الزكاة ، أو برمية بالبخل والشح ، أو كان المنفق يقصد من وراء إظهار الصدقة تشجيع الآخرين ، وتعويدهم على فعل الخير وإنعاش هؤلاء الضعفاء المحرومين ففي مثل هذه الموارد لابد من الاعلان للأسباب المذكورة ، أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فإن الأخفاء
ص: 118
أفضل نظراً لما يحققه من الأهداف السامية - كما بينا ذلك -.
من الصفات الممدوحة التي يرغب الله أن يتحلى بها المنفق هي ما ذكرته الآية الكريمة في قوله سبحانه :
(وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (1).
نفوس خيرة مؤمنة تتوجه إلى خالقها في كل صغيرة ، وكبيرة لتكسب رضاه ، ولتوطد العلاقة معه.
نفوس آمنت بربها فتسابقت إلى العمل بما يرضيه فقالت عنهم الآية الكريمة :
(وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ) .
والإيثار : هو احتساب الشيء ، وتقديمه على ما سواه في الوقت الذي تكون حالة مثل هؤلاء الأشخاص كما عبرت عنهم الآية : (وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) .
والخصاصة : هي الحاجة ، والاملاق فإذا كان الإيثار على النفس مع الحاجة الشديدة الملحة فإن ذلك غاية ما يتصور في تحلي الواحد من هؤلاء بالخلق الرفيع.
ومن هم هؤلاء الذين ذكرهم القرآن ، وأهاب بنفوسهم الرفيعة ؟
يقول المفسرون : هؤلاء قوم اكلهم الفقر ، فكانوا بأشد الحاجة إلى المال ولكنهم مع ذلك حفظوا أنفسهم ، وقدموا ما عندهم من المال إلى السائل ؛ والمسكين يبتغون بذلك رضا الله ، والتقرب إليه ، فوصفهم سبحانه بأنهم (الْمُفْلِحُونَ) فقال في نهاية الآية المذكورة : (فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) . وهم الفائزون بما وعدهم به من الثواب الجزيل.
وقد قيل في سبب نزول هذه الآية « أن رجلاً جاء إلى النبي صلی الله علیه و آله فقال :
ص: 119
أطعمني فإني جائع ، فبعث النبي إلى أهله فلم يكم عندهم شيء فقال : من يضيفه هذا الليلة ؟ فأضافه رجل من الأنصار ، وأتى به إلى منزله ولم يكن عنده شيء إلا قوت صبية له ، فأتوا بذلك إليه ، وأطافؤا السراج ، وقامت المرأة إلى الصبية ، فعللتهم حتى ناموا ، وجعلا يمضغان لسانيهما لضيف رسول الله صلی الله علیه و آله فظن الضيف أنهما يأكلان معه حتى شبع الضيف ، وباتا طاويين فلما أصبحا غدوا إلى رسول الله فنظر إليهم ، وتبسم ، وتلا عليهم هذه الآية :
وقد عقب الشيخ الطبرسي في تفسيره على هذه الآية بقوله :
« وأما الذين رويناه بإسناد صحيح عن أبي هريرة إن الذي أضافه وأنام الصبية وأطفأ السراج هو علي بن أبي طالب وفاطمة علیهاالسلام (1).
لقد أضاف الإيثار المذكور ثواباً آخر إلى ثواب الإنفاق نفسه ، وبذلك حصل المنفق الذي آثر غيره عليه على ثوابين :
ثواب على عطائه وإنفاقه لوجه الله سبحانه.
وثواب على إيثاره غيره على نفسه.
الذين يسخرون من المتصدقين : كما توجد نفوس مؤمنة خيرة تتجه إلى خالقها للتقرب إليه كذلك توجد نفوس شريرة همّها النفاق ، والبعد عن ساحة الله ، ورضوانه.
وهذا القسم الثاني عندما نلاحظ أعمالهم في المجتمع نجدهم لا هم لهم إلا العبث ، والشغب ، وإيذاء المنفقين بالسخرية منهم على إنفاقهم وهؤلاء هم المنافقون الذين يعيبون على المنفقين إنفاقهم ، ويطعنون في عملهم ويؤولون ذلك على حسب ما تشتهيه نفوسهم القذرة.
في هؤلاء يقول سبحانه :
(الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا
ص: 120
يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (1).
وفي سبيل نزول هذه الآية « قيل أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلی الله علیه و آله بصرةٍ من دراهم تملأ الكف ، وأتاه عتبة بن زيد الحارثي بصاع من تمر وقال : يا رسول الله : عملت في النخل بصاعين فصاعٌ تركته لأهلي ، وصاع أقرضته ربي.
فقال : معتب بن قشير ، وعبد الله بن بنثل إن عبد الرحمن بن عوف رجل يحب الرياء ، ويبتغي الذكر بذلك ، وإن الله غني عن الصاع من التمر ، فعابوا المكثر بالرياء ، والمقل بالاملاق(2).
إن الحقد الدفين يظهر من خلال هذا العيب فلا المكثر في الصدقة مقبول في نظرهم ، ولا المقل بل هم في دوامة من السرخية لمن تطوع بالصدقة ... لذلك رد الله سخريتهم بقوله سبحانه : (سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ) .
وطبيعي أن سخر الله هي : أن كتب لهم نار جهنم خالدين فيها ولهم عذاب اليم.
هذه صفة ممدوحة من صفات المنفق وهي : قبول السائل وعدم رده.
يقول الخبر عن الإمام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام :
« إن رسول الله صلی الله علیه و آله ما منع سائلاً قط إن كان عنده أعطى وإلا قال : يأتي الله به » (3).
وجاء فيما ناجى الله به موسى بن عمران علیه السلام أنه قال :
« يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو بردٍ جميل »(4).
كل ذلك لئلا يخرج السائل كسير القلب مردوداً من قبل المعطي.
ثم من يدري فلعل عملية السؤال تكون امتحاناً من الله للمنفق ليراه الله
ص: 121
ويكشف عما تجيش به نفسه من حبه للخير للجميع بغض النظر عن الفقير ، أو من كانت نفسه غيره طيبة ، ويتحلى بضعف بحيث يرضى لنفسه أن ينزل إلى مثل هذا المستوى الضحل من الذل والإنكسار وقد جاء عن رسول الله صلی الله علیه و آله قوله :
« ردوا السائل ببذل يسير وبِليْنٍ ورحمة فأنه يأتيكم حتى يقف على بابكم من ليس بإنس ولا جان ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله » (1).
وفي حديث آخر عنه صلی الله علیه و آله ان السائل قد يصرح ويقول :
« انني رسول من الله لأبلوك فوجدتك شاكراً فجزاك خيراً »(2).
سبق لنا أن بينا في مقدمة الكتاب أن موضوع بحثنا هو الفقير العاجز لا الفقير المتسول الذي يتخذ من التكفف وملاحقة الناس مكسباً له فإن إعطاء مثل هذا المتحرف تشجيع على البطالة ، والاحتيال على جيوب الناس ومضايقتهم في أغلب الأوقات ومثل هذا الشخص يبغضه الله - وسنتعرض فيما سيأتي - إلى ذكر بعض الأحاديث التي صرحت بأن السائل لو لم يكن فقيراً ، ومد يده يتكفف ، فكأنما يتناول الخمر ، أو أن جزاءه النار ، أو يأتي يوم القيامة مخموش الوجه.
وقد يرد السؤال عن التوفيق بين هذه الأخبار التي يظهر منها بغض الله سبحانه للسائل ، وبين الأخبار المتقدمة التي تقول : إن رسول الله صلی الله علیه و آله ما منع سائلاً قط ، أو ما جاء في مناجاة لله لموسى بن عمران من قوله تعالى : ( يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو ببردٍ جميل ) .
لأن الأخذ بظاهر هذه الأخبار إكرام السائل بإعطائه أو برده رداً جميلاً لو لم يكن المعطي يرغب في إعطائه ، ومعنى ذلك تشجيع السائل على التسول لأنه يجد فيه مرتعاً خصباً ، ومكسباً يدر عليه المال ، فهو اينما يتوجه يجد فيه مرتعاً خصباً ، ومكسباً يدر عليه المال ، فهو اينما يتوجه يجد من يكرمه ولا يرد له طلباً.
والجواب عن ذلك : أن الأخبار لم تأمرنا باعطاء المال على كل حال بل خيرت
ص: 122
المعطي بين الإعطاء والرد وحينئذٍ فإن عرف حال السائل ، وأنه متسول رد رداً جميلاً أما لو كان محتاجاً ، وفقيراً ، أكرم ، وأعطى.
على أن هذه الأخبار ، وإن أطلق فيها لفظ السائل الشامل لكليهما المتوسل المحترف والمحتاج الحقيقي إلا أن الأخبار المصرحة : بأن النار جزاء المتسول تقيد إطلاق تلك الأخبار فتكون النتيجة : عدم رد السائل الواقعي ، ورد السائل المحترف طبقاً لأخبار التقيد ، وبذلك تنحل مشكلة التسول.
بذلك صرحت بعض الأخبار تبين بأن دعوة السائل في حق المنفق تستجاب لذلك نرى الأئمة علیهم السلام يحثون المنفق أن يطلبوا ممن يسألهم حاجة أو شيئاً من المال أن يدعو لهم.
وبهذا الصدد نرى أمير المؤمنين علیه السلام يقول : « إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم » (1).
وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام أن علي بن الحسين علیه السلام قال :
« ما من رجل تصدق على مسكين مستضعف ، فدعا له المسكين بشيء تلك الساعة إلا استجيب له » (2).
ويقول الإمام زين العابدين علیه السلام في حديث له : « دعوة السائل الفقير لا ترد » (3).
وقد تكرر هذا الارشاد منهم ( صلوات الله عليهم ) في حق المعطين ، وان يطلبوا من السائل الدعاء لأنهم يستجاب في حقهم حيث نبه على هذا المعنى الإمام زين العابدين علیه السلام في حديث آخر له فقال : « إذا اعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه
ص: 123
يستجاب بهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم »(1).
ومن أدب العطاء أن لا يرد المعطي الصدقة إذا أخرجها ليعطيها إلى الفقير فليس من المستحسن أن يردها من غير فرق في السبب بين أن يكون السائل قد رفضها ، أو لم يجد سائلاً ، أو ما شاكل ذلك من الأسباب.
يقول الإمام أمير المؤمنين علیه السلام : « من تصدق بصدقة فردت عليه ، فلا يجوز له أكلها ولا يجوز له إلا انفاقها إنما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أن رجلاً أعتق عبداً لله ، فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقة » (2).
وعن الإمام الصادق علیه السلام عندما سئل عن رجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب فقال :
« فليعطها غيره ، ولا يردها في ماله »(3).
إن الأمر بعدم ارجاع الصدقة يجسد لنا الحرص الشديد على أن يبقى الثواب الذي حصل عليه المعطي مجرداً له فلا يفوت ما حصل عليه بإرجاع الصدقة ، بل يبقيها لينال ثوابه.
ص: 124
(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (1).
مع الآية في مقاطعها :
(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) .
الحصر : هنا بمعنى المنع ، ويقول المفسرون : أن الآية الكريمة تحدثت عن مجموعة من الفقراء كانوا في المدينة ، وهم من أهل الصفة ، وأهل الصفة فقراء يتواجدون حول المسجد النبوي ، أو أمامه في رحبته خارج المسجد حسبوا أنفسهم عن العمل للمعاش.
وقد اختلفوا في سبب هذا الحبس.
فقيل : أنهم فعلوا ذلك لأنهم هيأوا أنفسهم للجهاد خوفاً من الكفار.
وقيل : إن بعضهم منعه المرض من الكسب ، والتجارة.
وقيل : إنهم انصرفوا للعبادة.
وقيل : غير هذا ، وذاك من الأسباب.
إلا أن الذي لا خلاف فيه هو أن هؤلاء لم يستطيعوا العمل ، والكسب ، وهو المقصود بقوله تعالى : (لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ) .
هؤلاء الفقراء لشدة تحملهم ، وظهورهم بالمظهر اللائق الذي يحفظ لهم
ص: 125
كرامتهم ، وعزتهم ، وعدم مد يد الذل إلى الغير هو الذي جعلهم أغنياء في نظر الناس ممن يجهل حالهم ، وإنما عرفوا مما بدأ عليهم ، وظهر من آثار الجوع ، أو رداءة الملبس وإلا فانهم يحملون بين جوانبهم قلوباً ملؤها الإيمان بالله ، ونفوسا أبية تأبى أن تلوي جيداً لغير الله سبحانه.
(لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) .
أي وعلى فرض طلبهم وسؤالهم من الناس لو الحت الحاجة بشكل اضطرهم إلى السؤال فإنهم يسألون بهدوء ، وبرفق يتناسب مع ما هم عليه من التعفف وما يتحلون به من رفعة ، وإباء.
وليأخذ الفقراء من هذه الآية درساً قيماً يكيفون به أوضاعهم على نحو ما ترسمه من التحدث عنهم ، وليثقوا بأن الله هو الرازق ، وهو المقدر ، وأنه لا يضيع من يتكل عليه.
صحيح أن المعطي يعطي لوجه الله ، والتقرب إليه ، ولكن لا ينافي ذلك أن يجد المنفق من السائل تجاوباً على عطيته ، فيقابله بالشكر لله ، والدعاء له وبذلك يقوم برد بعض الجميل له ، ولعل ذلك يكون تشجيعاً للمعطي فيكرر العطاء له ، أو لغيره من المحتاجين.
نستفيد كل ذلك من الحديث الذي يحدثنا به أحد الرواة قائلا :
« كنا عند أبي عبد الله علیه السلام بمنى ، وبين أيدينا عنب نأكله ، فجاء سائل فسأله فامر له بعنقود فأعطاه فقال السائل : لا حاجة لي في هذا إن كان درهم فقال : يسع الله عليك ، ولم يعطه شيئاً فذهب ، ثم رجع فقال : ردوا العنقود فقال : يسع الله عليك ، ولم يعطه شيئاً ، ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله علیه السلام ثلاث حبات عنب ، فناولها إياها فأخذها السائل من يده ثم قال : الحمد لله رب العالمين الذي رزقني.
فقال أبو عبد الله : مكانك فحثا ملأ كفيه عنباً ، فناولها إياه ، فأخذها السائل من يده ثم قال : الحمد لله رب العالمين.
ص: 126
فقال أبو عبد الله : مكانك يا غلام أي شيء معك من الدراهم ؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً أو نحوها فناولها إياه ، فأخذها ثم قال : الحمد لله ، هذا منك وحدك لا شريك لك فقال أبو عبد الله : مكانك ، فخلع قميصاً كان عليه فقال : ألبس هذا ، فلبس ، ثم قال : الحمد لله الذي كساني ، وسترني يا أبا عبد الله. أو قال : جزاك الله خيراً ثم إنصرف وذهب » (1).
لنقف مع هذه الرواية وندفع عنها ما يرد عليها من إشكال مفاده :
ما يقال : من أن الإمام كيف يرد السائل الأول لمجرد أنه لم يرغب في أخذ عنقود من العنب بل أراد درهماً ، وما يدرينا ، فلعل السائل كان محتاجاً إلى المال لا للعنب فما معنى رد الإمام له ، ولا أقل أن نطلب من الإمام علیه السلام أن يسأل عن سبب رد السائل العنب ، وطلبه الدرهم ؟
والجواب عن هذا الأشكال : بأن الإمام الصادق علیه السلام ربما كان يقصد من هذا الرد للسائل أن يعطي درساً لمن حضر ، ولمن يصله الخبر في أدب السؤال ، وذلك بتنبيه السائل بأن أدب السؤال يقتضي عدم رد العنب لأن رده تحقير للمنفق على عطائه ، بل كان أدب السؤال يقضي بقول الهدية ، ثم المطالبة بالمال واظهار الحاجة له أما هذه المقابلة بالرد فإنها غير مستساغة.
وعلى العكس من السائل الأول نرى السائل الثاني بقبوله لحبات العنب الثالثة وحمده لله على الرزق حفز الإمام على الزيادة بالعطاء ، وكرر السائل الحمد فكرر الإمام العطية ، وعاد السائل يحمد الله سبحانه فعاد الإمام بالمال ، وحمد السائل مجدداً فخلع الإمام قميصه عليه فانصرف السائل وقد حصل على العنب ، والدراهم ، والقميص وكان ذلك نتيجة حسن تصرف السائل في قبوله العطاء بينما حرم السائل الأول من كل ذلك نتيجة سوء تصرفه وأسلوبه المعوج في تقبله العطاء.
ص: 127
السؤال والتكفف ليس حرفة وليس هو - في نفس الوقت - هواية ليقصد الإنسان من وراء ذلك جمع المال ، والعيش على حساب الآخرين ... بل لابد من أن يكون السؤال نابعاً عن حاجة السائل وعوزه وفي غير هذه الصورة فإن الشارع المقدس يمقت هذا النوع من التكفف ، ومد اليد إلى الآخرين وبالتالي يتوعد السائل لو تكفف من غير حاجة ، ولا احتياج.
يقول الأمام أبو عبد الله علیه السلام :
« ما من عبد سأل من غير حاجة ، فيموت حتى يحوجه الله إليها ، ويثبت الله له بها النار » (1).
وفي حديث آخر نراه يقول :
« من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الخمر » (2).
وقبل أن ننتقل إلى موضوع آخر من بحثنا لابد من الإجابة على السؤال عن هذا التشديد على السائل لو سأل من غير حاجة ، فإن مثل هذا السائل أقصى ما يقال في حقه : أنه نزل إلى المستوى الواطئ فرضي بالعيش ذليلاً يطلب من هذا ، ويسأل من ذاك وهذا أمر يخصه ، وعليه ينطبق عليه قول الشاعر :
« ومن لم يكرم نفسه لم يكرم ».
فلو ارتضى الشخص لنفسه أن لا يكرم فهل يكون جزاءه النار كما في الخبر الأول ، أو انه كمن اكل الخمر ؟ والمراد بالأكل هو شربها.
سؤال ينتظر الإجابة ؟
والجواب عن ذلك : ان الإسلام لا يرضى للفرد أن يكون كلاً على الآخرين ، بل يحبذ للإنسان الاعتماد على النفس ، والجد في هذه الحياة ليأكل قوته من ثمرة جهوده التي يبذلها في الكسب ، والتجارة ، والعمل ، وقد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله في موارد كثيرة
ص: 128
نهيه عن السؤال ، وإرشاد السائل بترك التكفف ، والدخول إلى معترك الحياة من الطريق الذي يحبذه الله لعباده وهو الطريق الذي سار عليه الأنبياء ، والأوصياء ، والصالحون كما حدثنا التاريخ عنهم ، وأنهم كانوا يعيشون من أعمالهم اليدوية ، أو البدنية.
يقول الإمام أبو عبد الله الصادق :
« لو أن رجلاً أخذ حبلاً فيأتي بحزمة حطبٍ على ظهره فيبيعها فيكف بها خير له من أن يسأل » (1).
وعنه أيضاً عن النبي صلی الله علیه و آله أنه قال :
« الأيدي ثلاثة : يد الله العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد المعطى أسفل الأيدي فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم. إن الأرزاق دونها حجب ، فمن شاء قنى حيائه ، وأخذ رزقه ومن شاء هتك الحجاب ، وأخذ رزقه ، والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلاً ، ثم يدخل عرض هذا الوادي ، فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه ، ثم يدخل السوق ، فيبيعه بمدٍ من تمر فيأخذ ثلثه. ويتصدق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه »(2).
رزق حلال حصيلة جهد ، وعمل ، وربح ، وتجارة مع الناس ، ومع الله.
مع الناس : فيما حصله من ثمن ما احتطبه من ثلث المال.
ومع الله : فيما أنفقه من ثلثي الحطب ، أو قيمته إلى الفقراء ، وبذلك يسد حاجته ، وحاجة غيره.
كل ذلك خير له من مد يد الذلة إلى الناس ينتظر ما تدر به عواطفهم نحوه.
على أن السائل بمد يده إنما يقصد إنساناً مثله فهو بهذه العملية يعرض عن التوجه إلى الله سبحانه ويبعد عن ساحته المقدسة ولو كانت ثقته بالله متينة ورصينة لما أعرض إلى غيره.
يقول لقمان الحكيم لولده : « يا بني ذقت الصبر ، وأكلت لحا الشجر ، فلم أجد
ص: 129
شيئاً امر من الفقر ، فأن بُليت به يوماً ، فلا تظهر الناس عليه ، فسيهينوك ، ولا ينفعوك بشيء إرجع الذي ابتلاك به فهو اقدر على فرجك ، واسأله فمن ذا الذي سأله فلم يعطه ، أو وثق به فلم ينجه ؟ » (1).
« فمن ذا الذي سأله فلم يعطه ، أو وثق به فلم ينجه » ؟
استفهام إنكاري يحمل بين طياته دروساً قيمةً ، فالسائل هذا الإنسان العبد المخلوق والمسؤول هو الله سبحانه.
الله : الذي كرر في آيات عديدة من كتابه الكريم ضمانه للأجابة لو دعاه العبد.
الله : الذي تطوف ملائكته في أناء الليل ، وهم ينادون :
هل من داعٍ فيستجاب له ؟
هل من طالب حاجة لتقضى له ؟
هل من تائب ليقبل الله توبته ؟
لقد نام الملوك ، وغلقوا أبواب قصورهم ، وطاف عليها حراسها ، وبابه مفتوح لمن قصده.
الله : الذي تكفل بأرزاق العباد فقال في كتابه الكريم :
(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) . بغض النظر عن مساويء العباد.
الله : يخاطب عباده في حديث قدسي قائلاً :
« عبدي أوجدت صدراً أوسع مني فشكوتني إليه ».
هذا الله العظيم هل يرد سائلاً مد يده إليه ؟
أو يوصد باب رحمته بوجه من طرق ذلك الباب ؟
أو يمنع رزقه عمن اتكل عليه ؟
إذاً لماذا يتجه السائل إلى إنسان مثله فقير إلى ربه ؟
ص: 130
صلة الرحم ، وقطيعة الرحم ككل تعرضت لهما الآيات الكريمة ، والأخبار بصورة مكثفة ، وكلها تحذر من القطيعة ، وعدم التودد إلى الأرحام.
وقد بينت الأخبار ، وكشفت عن العواقب الوخيمة التي تترتب على التفكك الذي يحصل بين الأقرباء مهما كان السبب في ذلك التقاطع ، والتباعد ، ولكنها - في الوقت نفسه - أهابت بأبناء الأسرة الواحدة أن يتقاربوا حول بعضهم وينشدوا ، ويكونوا كالجسم الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله.
يقول سبحانه :
(وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ- إلى قوله - أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) (1).
وفي آية أخرى :
(وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) (2).
مقابلة دقيقة بين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، وبين الذين يقطعون ما أمر الله أن يوصل ، فلأولئك عقبى الدار ، ولهؤلاء سوء الدار.
والدار في الموضعين هي : الدار الآخرة. وعقبى الدار هي الجنة. وسوء الدار هي ، النار.
وما أمر الله به أن يوصل وإن كان في لسان الآية عاماً مشمولة للآيات والأخبار.
وهكذا الحال في قطيعة الرحم أيضاً فإنها تكون مشمولة إلا أن صلة الرحم من جملة ما أمر الله به أن يوصل فتكون على نحو ما هو الحال في صلة الرحم وبهذا
ص: 131
الصدد تقول الآية الكريمة :
(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (1).
وقد سأل أحد الرواة من الإمام علیه السلام عن قوله سبحانه :
(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ) فأجاب علیه السلام بأنها أرحام الناس إن الله أمر بها أن توصل ، وعظمها ألا ترى أنه جعلها منه (2).
والمراد من قوله علیه السلام جعلها منه أي قرنها باسمه في الأمر بالتقوى.
ويقول عز وجل في آية آخرى :
(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى) (3).
ومن خلال هذا الآية تظهر لنا أهمية الإحسان بالوالدين ، وبذي القربى حيث أوص الله بهم وقد قرن هذه الوصية بالأمر بعبادته ، وعدم الشرك به. ومن الواضح ما للأمر بعبادته من الأهمية بالنسبة إليه ، وهكذا عدم الشرك ، قد صرحت الآية الكريمة بذلك في قوله تعالى :
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (4).
وقد استفاضت الأخبار بالإشادة بصلة الأرحام والحث على التودد إليهم يقول الإمام الرضا علیه السلام : « يكون الرجل يصل رحمه ، فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين ، فيصيرها الله ثلاثين سنة ، ويفعل الله ما يشاء »(5).
وعن الإمام محمد الباقر علیه السلام قوله : « صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي
ص: 132
الأموال ، وتدفع البلوى ، وتيسر الحساب وتنسيء في الأجل »(1).
وفي خبر آخر : « صلة الرحم تحسن الخلق ، وتسمح الكف ، وتطيب النفس ، وتزيد في الرزق ، وتنشئ في الأجل »(2).
وليس المراد بصلة الرحم هو الاقتصار على الأمور المالية ومد يد المساعدة إليهم بل القصد من وراء ذلك إظهار العطف والود وعدم الإنقطاع عنهم.
وقد ضرب الإمام الصادق علیه السلام مثلاً لأدنى ما يمكن إظهار للأرحام فقال :
« صل رحمك ولو بشربة من الماء » (3).
وقد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله ( قوله ) :
« أبغض الأعمال إلى الله الشرك بالله ثم قطيعة الرحم »(4).
وقد طفحت كتب الحديث بالأخبار التي تحدثت عن الخلفيات التي تترتب على قطيعة الرحم.
هذه لمحة عن صلة الرحم ، وقطيعتها على نحو العموم.
أما في خصوص الإنفاق عليهم ، ومساعدتهم بالمال ، ونحوه فقد جاء ذلك مصرحاً في الأخبار التالية.
فعن الإمام الصادق علیه السلام :
« الصدقة على مسكين صدقة ، وهي على ذي رحمٍ صدقة ، وصلة »(5).
وعن الإمام الحسين علیه السلام أنه قال : « سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول : إبدأ بمن تعول : أمك ، وأباك ، واختك ، وأخاك ، ثم أدناك ، فأدناك وقال : لا صدقة ،
ص: 133
وذو رحمٍ محتاج » (1).
وسئل النبي صلی الله علیه و آله : « عن أي الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح ».
هذا إذا أخذ الإنفاق على الأرحام من الأخبار الشريفة. ومن إطارها الذي يعتبر الصورة الأخرى المعبرة عن الكتاب المجيد.
وأما الانفاق من الناحية الإجتماعية ، فنراه مطابقاً لما تقتضيه الأصول الإجتماعية ... ذلك لأن الإعراض عنهم يكوم موجباً لزرع بذور الفتنة والقطيعة بين أفراد الأسرة الواحدة بينما حرص الإسلام على لمّ شملها ، وجمعها.
على أن الكثير من الناس يتقبل من الرحم ، وتسمح نفسه أن يتقبل من الإقرباء هدية بينما لا يخضع لغيره. ولا تسمح نفسه للجوء إليه مهما كلف الثمن.
ولهذا رأينا الأخبار تؤكد على البدء بالعطاء ، والاحسان إلى القرابة وفي مقدمتهم أهل المحسن كما جاء عن الإمام الحسين علیه السلام في حديثه المتقدم.
لقد تعرض القرآن الكريم إلى ذكر الإحسان ، والتشويق له ، وحث الناس على عمل الخير بشكل عام من دون بيان لخصوصية تلك الأعمال ، ونوعيتها ، وما يقدمه المحسن من النفع إلى الأخرين ... بل تركت الباب مفتوحاً أمام المحسنين ليشمل الإحسان كل ما ينفع المجتمع ، وينهض بالأفراد ، ولتعم الفائدة ، وليتسابق الناس إلى تقديم كل شيء يكون إحساناً ، وإلى كل فرد يحتاج لذلك الإحسان.
على أن الآيات الكريمة في عرضها لصور التشويق إلى الإحسان قد تنوعت في العرض المذكور.
تقول الآية الأولى :
( والله يحب المحسنين ) (2).
ص: 134
وجاء في الثانية :
(فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (1).
وفي الثالثة قال سبحانه : (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (2).
من مجموع هذا الآيات الثلاث نستفيد من النقاط التالية :
النقطة الأولى : إطباق الآيات الثلاث على الأخبار بأن الله يحب المحسنين ، ويمنحهم عطفه ووده.
النقطة الثانية : الفرق بين الثوابين الدنيوي ، والأخروي ، وأن أحدهما غير الآخر ، وإلا فلو كانا شيئاً واحداً لما عطف ثواب الآخرة على ثواب الدنيا كما جاء ذلك في الآية الثانية حيث قال سبحانه :
(فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ) (3).
ولو أراد وحدة الثواب لأخبر بأن المحسن يجازي بالثواب من دون تفصيل ، ويبقى الثواب على إطلاقه ليشمل كلا الثوابين : الدنيوي والأخروي.
وقد يقال في بيان الفرق بين الثوابين : أن ثواب الدنيا ما يعود إلى الرزق ، وعدم الابتلاء بالحاجة إلى الغير ، وحسن السمعة بين الناس ، ومنح المحسن العمر الطويل ، وما شاكل من القضايا التي يكون النفع فيها واصلاً إلى المحسنين في هذه الحياة.
وأما ثواب الآخرة : فهو الجنة والنعيم الدائم.
النقطة الثالثة : الأمر بالإحسان مضافاً إلى محبة الله للمحسن وقد جاء ذلك في الآية الثالثة في قوله تعالى : (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) .
وكما جاء في آية أخرى قال فيه سبحانه :
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) (4).
ص: 135
ولو لم نقل بأن الأمر في هذه الآية يدل على الوجوب الإلزامي بالعمل بالإحسان إلى الآخرين فلا أقل من القول بشدة مجبوبيته له سبحانه.
النقطة الرابعة : أن الآية الثانية قد اشتملت على أمرين :
الأول : ان الله يمنح الثواب لمن أحسن في الدنيا قبل الآخرة :
الثاني : بيان أن الله يحب المحسن.
ومن هنا نقول : لسائل أن يطلب التوضيح عما يكتنف هذه الآية من غموض بالنسبة لمحبة الله للمحسن ، وما تأثيرها بعد أن ضمن الله له الثوابين ، وعلى الأخص بعد أن فسر ثواب الآخرة بالجنة ، فمن وعد بالجنة ما يصنع بثواب الدنيا ؟.
والجواب عن ذلك : أن محبة الله لعبده نوع تكريم من الله لعبده فهو بهذا الانعطاف إليه يحيطه بهذه الرعاية الخاصة ، وهذا اللطف الإلهي ، فيجعل المحسن محبوباً إليه.
ان المحسن له الحق أن يفتخر بهذا الشرف الرفيع ، وإن كان قد منحه الله الجنة في الآخرة وهذا هو ثوابه في الدنيا ومحبة الله له.
ويتجلى هذا اللطف الكريم من خلال الآية التي رعت المحسن ، فمنحته شرف رعاية الله له بمعيته فقال سبحانه :
(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) (1).
والإحسان في هذا الآيات ، وإن كان عاماً يشمل الإنفاق وغيره ، ولكن - كما قلنا - أن الإنفاق أحد مصاديق الإحسان ، ويكفي للمنفق أن يكون من جملة من يشمله اطلاق هذه الآيات الكريمة التي تشكل من حيث المجموع ترغيباً وتشويقاً للإنسان في الإنفاق باعتباره إحساناً إلى الغير.
ص: 136
1 - عطاء بمقدار من المال يرفع به المنفق حاجة الفقير الوقتية ويدفع عنه بعض المصاعب التي يواجهها في حياته اليومية نتيحة فقد انه المال.
2 - وعطاء يتميز بالمال الكثير يقدمه المعطي هدية للفقير ليستعين به على تبديل حالته وتغيير مجاري حياته المالية من الفقر إلى الغنى.
ونحن أمام هذين العطاءين :
فالأول منهما : لا يحل مشكلة الفقير ، ولا يعالج قضية الفقير من الجذر إذ لا يريح المحتاج ، ويخلصه من ويلات الحرمان.
أما الثاني : فإنه يحقق هذه الغاية وينحو نحو هذا الهدف السامي لأنه يتناول المشكلة ، فيعالجها من الأساس بإقتلاع جذورها العميقة ، وبذلك تكون هدية المعطي من القسم الثاني ليس لإنعاش الفقير فقط بل خدمة يقدمها إلى مجتمعه بتبديل عناصر لها خطورتها بعناصر طيبة يرجى منها كل الخير.
لذلك لا عجب إذا رأينا أهل البيت علیهم السلام ينحون في عطائهم إلى تحقيق هذه الغاية فنشاهد أغلب الوقائع التي كانوا يقدمون فيها العطاء إلى المحتاجين كان الإنفاق فيها من القسم اثاني فلم يكن عطاؤهم نزراً يقصدون به رفع حاجة الفقير الوقتية ولئلا يرجع السائل عن بابهم بخيبة أمل ، بل كان عطاؤهم وفيراً يقصدون فيه تبديل حالة السائل وتغيير عنوانه من فقير عاطل إلى غني عامل.
تقول مصادر التاريخ أن الإمام الحسن بن علي علیهاالسلام اعطى سائلاً قصده خمسين ألف درهماً وخمسمائة دينارٍ ، وأعطى طيلسانه للحمال الذي جاء ينقل هذا المال وفي واقعة أخرى نراه ( صلوات الله عليه ) يعطي سائلاً قصده عشرين ألف درهم وعندما شاهد السائل هذه الأريحية ، وهذا الكرم قال والحيرة تأخذ عليه مسالك التفكير :
ص: 137
يا مولاي الا تركتني أبوح بحاجتي ، وأنشر مدحتي.
فأجابه الإمام : وهو يردد هذه الأبيات.
نحن أناس نوالنا خضل *** يرتع فيه الرجاء والأمل
تجود قبل السؤال أنفسنا *** خوفاً على ماء وجه من يسل (1)
إن آل البيت الهاشمي عندما يعطون شعارهم في العطية ( إذا أعطيت فأغني ).
وهذا معنى العطاء الجزل الذي حصل أغنى من وصل إليه.
ولنقف أمام هاتين الواقعتين من عطاء الإمام علیه السلام فبالامكان أن نستفيد من خلالهما الأمور التالية :
الأمر الأول : أدب العطاء ويظهر ذلك من مبادرة الإمام بالعطاء قبل أن يبدأ السائل بالمسألة وبذلك حفظ له كرامته فلم يمهله ليعرض عليه حاجته وتبدو على وجهه إمارات الذل ، بل بادره بقضاء حاجته.
وقد حصل مثل ذلك لسائل آخر في مجلس الإمام الرضا علیه السلام فقد نقل لنا أحد الرواة أن سائلاً سأل الإمام أن يعطيه مقداراً من المال لأنه فقد نفقته فقال له :
« قد افتقدت نفقتي وما معي ما ابلغ به مرحلة فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي ».
ويأتي الجواب من الإمام قائلاً : اجلس رحمك الله ، ثم دخل الحجرة ، وخرج ، وقد رد الباب وأخرج يده من أعلى الباب ، وقال اين الخراساني ؟ فقال : أنا ذا.
فقال : خذ المائتي دينار فاستعن بها في مؤنتك واخرج فلا أراك ولا تراني ثم خرج.
وهنا تكلم أحد الحاضرين قائلاً : جعلت فداك لقد أجزلت ورحمت فلماذا سترت وجهك عنه ؟ فقال : مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته.
أما سمعت حديث رسول الله صلی الله علیه و آله المتستر بالحسنة تعدل سبعين حجة والمذيع
ص: 138
بالسيئة مخذول ، والمتستر بها مغفور له أما سمعت قول الأول :
متى آته يوم أطالب حاجة *** رجعت إلى أهلي ووجهي بمائة (1)
الأمر الثاني : اغناء السائل. إن الإمام عندما يعطي هذا المقدار من المال وبهذه الكثرة لا يخلوا الحال فيه :
فإما أن يكون من بيت مال المسلمين حيث يتصرف فيه بحسب ولايته الشرعية وهو أعرف بصرفه.
أو أنه من ماله الشخصي ويتصرف فيه تصرفاً شخصياً.
وفي كلتا الحالتين لا يتصرف جزافاً ولا يجوز لنا أن نقول : إنه بعمله هذا يبعثر المال.
ولعل الحكمة من ذلك هو إنعاش الفقير بإغنائه ليكون ما يقدمه له مساعدةً لتغيير حالته من الفقر إلى الغنى فيستعين بذلك المال على الكسب ، والتجارة وشق طريقه في هذه الحياة على نحو أفضل مما هو عليه ، فهو بعمله هذا ينقذ إنساناً شاءت الأقدار أن تسوقه إلى هذا المجرى من العيش الردئ.
3 - شمولية العطاء :
ولم يقتصر عطاء الإمام على السائل ، بل كان للحمال الذي جاء لنقل المال حصة من الإحسان حيث قدم له الإمام طيلسانه ، ولا بد أن نعرف أن طيلسان الإمام ليس شيئاً عادياً ، وإلا فلو كان شيئاً عادياً لما قدمه لهذا المسكين ولو كان حمالاً إن الإمام علیه السلام بهذه الهدية يريد ارضاء جميع الأطراف ، وعدم خروج فقير من الفقراء من مجلسه كسير النفس ، ولذلك أرضى حتى الواسطة في النقل فطابت نفس الحمال وهو يضع الطيلسان على كتفيه.
هذه لون من العطاء.
ص: 139
وهناك لون آخر نشاهد وقائعه تمر مع مسيرة الإمام علي بن الحسين علیهاالسلام الحياتية فإن عطاءه كان يشتمل على نحوين من الإحسان.
تقول مصادر التاريخ ان الإمام زين العابدين علیه السلام كان يخرج في الليل وهو يحمل الطعام ، والكساء ، والدراهم ، والدنانير ، وربما حمل الحطب على كتقه ليوزع كل ذلك على الفقراء ، وهو متنكر لا يريد أن يعرفه الفقراء ، ولكنهم عرفوه بعد وفاته لأنهم افتقدوه بعد انقطاعه عنهم.
وليس هذا النوع من العطاء بعيداً عن الإمام زين العابدين علیه السلام فقد تلقاه عن مسيرة جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام وشاركه بهذه المسيرة أولاده ، وأحفاده من أئمة أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) وكانوا يقولون لمن يعترض عليهم هذه الطريقة لما فيها من الانهاك ، والتعب ، ولربما بعض الشيء من النقص عندما تصدر من أحدهم وهو على جانب كبير من المهابة والأجلال : « صدقة الليل تطفئ غضب الرب ».
وكان كثير من الأئمة يسيرون على هذه الطريقة مع بعض أرحامهم وهم لا يعرفونه ولربما صدر من بعضهم الدعاء عليه لأنه لم يصله ، والإمام يغضي عن ذلك ولا يلتفت إليه لئلا يعرفه.
كل ذلك للحفاظ على كرامة المحتاجين والتستر على الحالة التي هم عليها.
ص: 140
لظروف وأسباب قد لا تكون خافية على من درس أوضاع الجزيرة العربية آنذاك وبقية الممالك ، والمدن التي كان سوق العبيد فيها رائجاً ، والتجارة بهم رابحة فإن الإسلام لم يواجه الأمة وهو في أول المسيرة بالغاء الرقيق إذ لم يكن بالإمكان منع ما جرى عليه العرف السائد في وقته.
وبما أن الإسلام حرص على غلق باب الرق ، وكان هذا من الأسس الأولية لبناء المجتمع الإسلامي لذلك عالج هذه المشكلة من طريقين :
الأول : غلق باب الرق ابتداءً إلا في حالة الحرب بين المسلمين والكفار جهاداً ، أو دفاعاً وبشروط يتعرض لها الفقهاء في بحوثهم الفقهية.
الثاني : تصريف ما كان موجوداً من الرقيق بفتح الباب لعتقهم حيث جعل من جملة ما يكفر به عند ارتكاب بعض الخطايا عتق الرقبة.
وهكذا فيمن ملك أحد العمودين جانب الإب ، أو الأم ، فإنه يعتق عليه قهراً.
ومثل ذلك موضوع الطوارئ القهرية التي تحل بالإنسان من الأمراض وغيرها. فإنه يعتق قهراً عند حلول ذلك الطارئ القهري كما لو قطعت يده ، أو رجله ، أو عمي وما شاكل.
وبعد كل هذا اخذ الإسلام يشوق الناس إلى التقرب إلى الله بعتق العبيد ، وجعل ثواباً عظيماً لمن يحرر نسمة ، ويخلصها من قيود العبودية ... وبذلك فتح الروافد الكثيرة لتصريف ما كان موجباً من العبيد لينهي مشكلة تأصلت بين الناس في ذلك الوقت (1).
ص: 141
وعلى هذا سار المحسنون فكانوا يتسابقون على شراء العبيد ، وعتقهم لوجه الله سبحانه وكان من جراء هذه الروافد تخفيف حدة العملية الرقية ، وكساد سوق الرقيق إلى أن وصل الأمر إلى تقلصها بل وانها قد انعدمت في أيامنا هذه.
ولكن الملاحظ من الواقع الذي يعيشه أهل البيت علیهم السلام اتجاه هذه المشكلة انهم لم يكتفوا بتصريف العبيد بشرائهم وعتقهم بل كانوا يقومون بأعمال أخرى تربوية واجتماعية مضافاً إلى عملية العتق والتحرير.
ولنبدأ مع الإمام علي بن الحسين علیه السلام من المراحل الأولى التي يشتري فيها العبد ويهيؤه للعتق :
المرحلة الأولى : وتبدأ بتعليم العبد ، وتثقيفه ثقافة إسلامية ، وتأديبية بالأداب التي يريدها الإسلام.
المرحلة الثانية : وبعد ذلك يعتقه لوجه الله لا على نحو الجزاء عن كفارة ليكون الغرض من العمل هو التقرب الصرف لله سبحانه ، ونيل مرضاته.
المرحلة الثالثة : تزويده بالمال ليساعده على الاستعانة به في الكسب والتجارة ليشق طريقة في هذه الحياة من جديد لا أن يكون كلاً على الناس كما كان كلاً على مولاه قبل عتقه.
وكان علیه السلام يتحين الفرص المناسبة لعتقهم ، ويكون ذلك في موسم الأعياد من شهر رمضان ، أو الأضحى ليضيف إلى فرحة العتق فرحة استقبال العيد بحرية كاملة.
أما معاملته معهم فكانت معاملة رقيقة تنسيهم ذل العبودية والرقية - وعلى سبيل المثال - فإن الإمام زين العابدين لم يكن يعاقب عبده لو صدر منه ما يوجب العقوبة بل كان يسجل عليه خطأه ، ويحصيه ، وينتظر إلى أحد العيدين رمضان ، أو الأضحى ، وعندها يجمعهم ، ويقرأ لهم ما ارتكبوه من الأخطاء كل ذلك يجريه معهم بلطف ، وأدب لا بزجز ، وخشونة. وبعد أن يأخذ منهم إعترافهم بما صدر منهم بعد تذكير كل منهم بوقت الخطأ ، ومكانة.
ص: 142
واذا ما تم كل ذلك أصدر حكمه عليهم بقوله :
قد عفوت عنكم.
ولم يكتف بذلك بل يقول لهم بعدها :
فهل تعفون عني ما كان مني إليكم ؟.
فيقولون : قد عفونا عنك وما أسأت.
وهل يكتفي بهذا المقدار من الإعتذار ، والتنازل ؟ ويأتي الجواب : لا ، بل يوقفهم ويكلفهم بإصدار عفوهم عنه بمظهر الدعاء قائلاً لهم :
قولوا : اللهم اعفوا عن علي بن الحسين كما عفا عنا (1).
وبعد أن يستجيبوا لما طلب منهم من العفو على هذا النحو من الدعاء يحررهم ، ويعتقهم لوجهه تعالى ، ويعطيهم بعض المال ليبدأوا بذلك مسيرتهم في حياتهم الجديدة.
ومن خلال هذه المسيرة مع الإمام علیه السلام في معاملة عبيده التي تتكرر كل عام مرة ، أو مرتين نتعرف على مدى ما يتحلى به الإمام علیه السلام من لطف ، وأدب ونفس رقيقة ، وروح تربوية عالية ، فهو لم يعاقب عبيده إذا أخطأوا ، بل يطلب منهم العفو ، وهو صاحب العفو ، ولا يتركهم يشعرون بالتقصير او التصاغر أمامه يطلب منهم العفو ، وهو من مصدر القوة.
ويكلمهم بهدوء ، واتزان ، وبلسان يقطر رقة قائلاً لهم :
فهل عفوتم عني ما كان مني إليكم ؟
ولنرى ما كان منه اليهم ؟ فمن كان يحمل مثل هذه النفسية الرفيعة ماذا يصدر منه طلية المدة التي يكونون ضيوفاً عليه في طريق تسريحهم إلى عالم الحرية.
ص: 143
ان الذي يصدر منه ما هو إلا الحنو ، والشفقة ، واللطف ، والرعاية بكل معانيها ، وقد عودهم أن يجالسهم ، ويأكل معهم ، ويلبسهم أحسن اللباس ، ولا يجور عليهم. كل ذلك ليعلمهم كيف يشقون طريقهم في حياتهم الجديدة بعد العتق.
معاملة طيبة ونتيجة حسنة.
فمن العبودية إلى الحرية.
ومن الجهل إلى العلم.
ومن الفقر إلى الغنى.
ولو فتشنا كتب التاريخ لرأينا هذه السيرة هي نفس السيرة التي جرى عليها بقية الائمة من أهل البيت علیهم السلام مع العبيد بل مع الفقراء والمحتاجين لا بل ومع كل أحد من الناس بغض النظر عن العناوين التي تميز بعض الناس عن بعضهم الآخر.
سلام الله عليكم يا أهل بيت النبوة ، وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي ، والتنزيل.
وسلام الله عليكم يوم ولدتم ، ويوم متم ، ويوم تبعثون ، وإن كنتم أحياء عند ربكم ترزقون.
عز الدين السيد علي بحرالعلوم
ص: 144
الصورة

ص: 145
الصورة
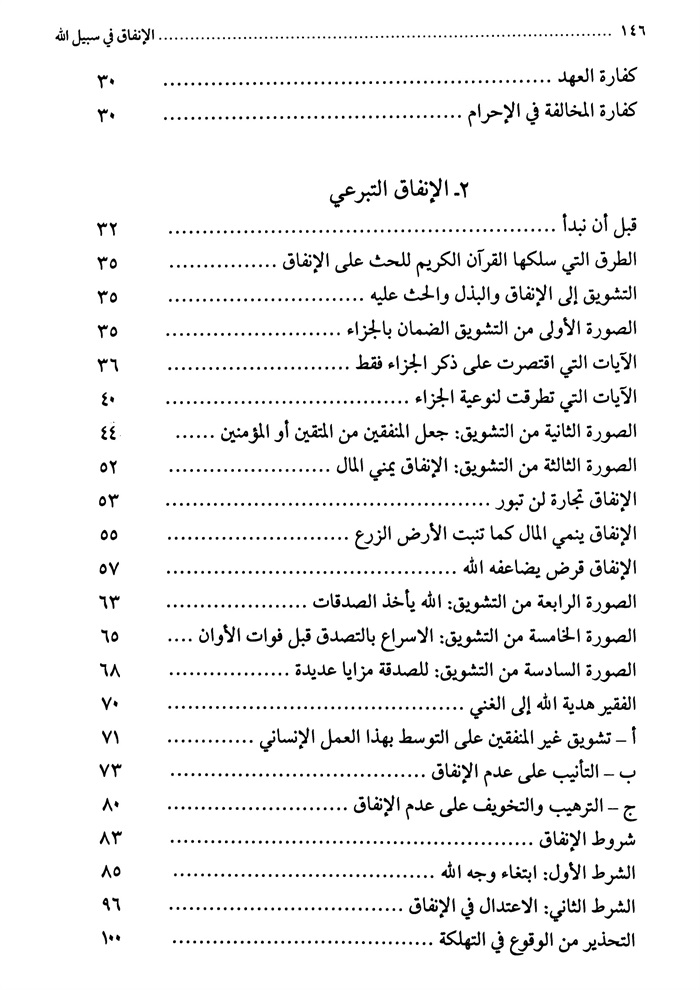
ص: 146
الصورة
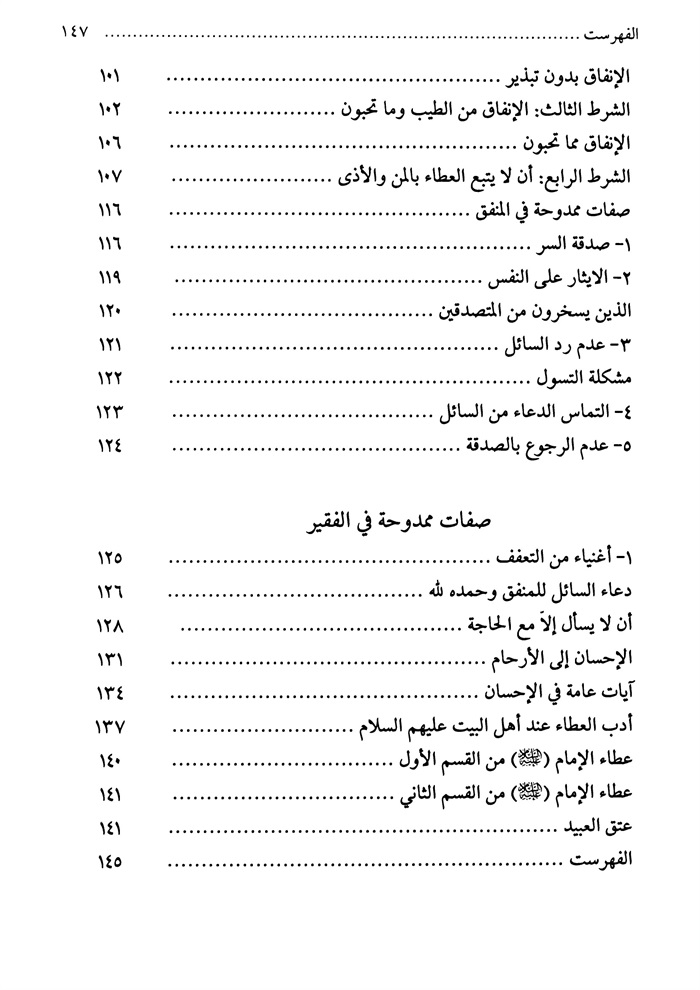
ص: 147