الملحق الأول
الصورة
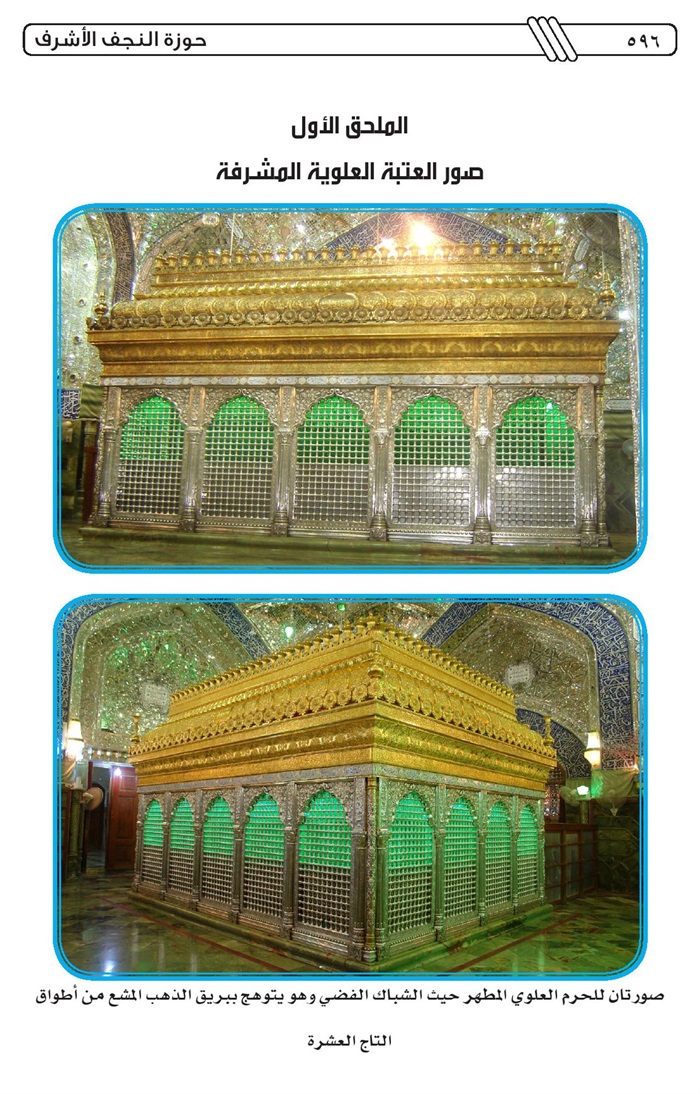
ص: 596
العَتَبَةُ العَبَاسِيَةُ المُقَدَّسَةُ
قسم الشؤون الفكرية والثقافية
شعبة الإعلام
حَوزَةُ النَّجَفِ الأَشْرَفِ
النظام ومشاريع الإصلاح
تأليف د. عبد الهادي الحكيم
وِحْدَةُ الْدِرَاسَاتِ وَ النَّشَرَاتِ
كربلاء المقدسة
ص.ب (233)
هاتف: 322600، داخلي: 175-163
www.alkafeel.net
info@alkafeel.net
الكتاب: حوزة النجف الأشرف النظام ومشاريع الإصلاح.
الكاتب: د. عبد الهادي الحكيم
الناشر : قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة / شعبة الاعلام.
الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.
تصميم: رائد الاسدي
الطبعة: الثالثة.
عدد النسخ: 2000
شعبان 1433 - حزيران 2012
جمعية خيرية رقمية: مركز خدمة مدرسة إصفهان
المحرر: محمّد رادمرد
ص: 1
العَتَبَةُ العَبَاسِيَةُ المُقَدَّسَةُ
قسم الشؤون الفكرية والثقافية
شعبة الإعلام
وِحْدَةُ الْدِرَاسَاتِ وَ النَّشَرَاتِ
كربلاء المقدسة
ص.ب (233)
هاتف: 322600، داخلي: 175-163
www.alkafeel.net
info@alkafeel.net
الكتاب: حوزة النجف الأشرف النظام ومشاريع الإصلاح.
الكاتب: د. عبد الهادي الحكيم
الناشر : قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة / شعبة الاعلام.
الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي.
تصميم: رائد الاسدي
الطبعة: الثالثة.
عدد النسخ: 2000
شعبان 1433 - حزيران 2012
جمعية خيرية رقمية: مركز خدمة مدرسة إصفهان
المحرر: محمّد رادمرد
ص: 2
بسم اللّه رب العالمين وله الحمد على ما أنعم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد،
فإنه غير خاف على أحد ما للحوزة العلمية في النجف الأشرف من دور مهم في سالف المسلمين وغابرهم، وحاضر المؤمنين ومستقبلهم، فلقد نهضت الحوزة العلمية النجفية والمرجعية الدينية بواجبها الملقى على عاتقها خير قيام، تفقها في دينها، وإنذارا لقومها، استجابة لقول باريها في محكم كتابه الكريم : « فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » فحافظت بحلم وحزم، وشجاعة وعزم، وصبر وكظم، على وجود الثلة المسلمة المؤمنة، حامية لثغرها، حافظة لبيضتها، راعية لخصوصيتها، ذائدة عن حياضها، موضحة لها معالم دينها، مبينة لها آداب شريعتها، صائنة لها تاريخ أئمتها، ومجلّية لها أصول عقيدتها. شارعة لها المنهج، وناهجة بها السبيل، في زمن غياب الدولة العادلة، وتحت ظل أنظمة الطغيان والطائفية والاحتلال، متحملة جراء ذلك الموقف الصعب ما تحملت من شؤون وأشجان، وآلام وأهوال، ومحن وأرزاء، ومكابدة وبلاء، جوراً من عدو غاشم حيناً، وقساوة من ابن ظالم أحياناً، ومع ذلك كله ظلت صابرة محتسبة، لم تثنها عن اتخاذ القرار الصعب عوائق ومصاعب، ولم تمنعها من الإقدام عليه ويلات ومصائب قاصدة وجه اللّه عز وجل قبل كل،وجه طالبة رضا اللّه جل وعلا قبل كل،رضا مطمئنة بقدر اللّه راضية بقضاء اللّه صابرة عند بلاء اللّه، شاكرة لنعماء اللّه ذاكرة لآلاء اللّه، مشتاقة إلى لقاء اللّه، مولعة بذكر
ص: 3
اللّه، موالية لأولياء اللّه، معادية لأعداء اللّه.
إن هذا التوصيف لواقعها أو شبهه جعلها محط أنظار الباحثين ومورد سؤال السائلين، لذا حاولت أن أكتب عنها، مجلِّيا بعض ما غمض من وضعها، ومضيئا بعض ما ادّلهم من أمرها على غير العارفين بها وبشؤونها، وذلك من خلال البحث التالي الذي يتضمن فيما يتضمن تمهيدا وسبعة عشر فصلا تتفرع إلى مباحث، وقد تتفرع المباحث إلى مطالب حسب الخطة.
فقد تناول التمهيد تبيانا مختصرا لعمارة المرقد العلوي الشريف السبب الرئيس إن لم يكن الأول والأخير، الداعي إلى نشوء الحوزة العلمية في النجف الاشرف، مجاورة إمامها باب مدينة علم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وأفقه وأقضى صحابته المنتجبين.
وتناول الفصل الأول منها الموسوم (الحوزة مصطلحا وتاريخا علميا موجزا) في مبحثين ثنتين تعريفا بمصطلح الحوزة العلمية، وإلماما موجزا ببعض من تاريخها العلمي الأصيل، مع تجلية لأدوار البحث العلمي، ووقوف قصير على فترات النضج المعرفي لمدرستها العلمية الجامعة.
وتناول الفصل الثاني منها الموسوم (مرحلتا المقدمات والسطوح كتبهما الدراسية وطريقة تدريسها) في مباحث ثلاثة تمهيدا حدّد مراحل الدراسة في حوزة النجف العلمية ثم عرّف أولا بمرحلة المقدمات وكتبها المعتمدة، ثم ثنّى فعرّف بمرحلة السطوح وكتبها المعتمدة، ووضح بعد ذلك طرائق التدريس المتبعة فيها.
وتناول الفصل الثالث الموسوم (مرحلة البحث الخارج نظامها وطريقة تدريسها ومثل تطبيقي عليها) في مبحثين ثنتين مرحلة التخصص العالي الدقيق هذه، حيث تطرّق في مبحثه الأول النظام الدراسي المتبع في هذه المرحلة الدراسية المتقدمة، وطريقة
ص: 4
التدريس المتبعة فيه. وقدّم في مبحثه الثاني مثلين تطبيقيين عليه لتقريب طريقة تدريس بحث الخارج السائدة فيه.
في حين تناول الفصل الرابع منه الموسوم (الاجتهاد) في أربعة مباحث معنى كلمة الاجتهاد في المعجم العربي والمصطلح، فمعدات الاجتهاد الشرعي، فإجازة الاجتهاد، ثم قدم في مبحثه الثالث نموذجين لها، مع إطلالة موجزة على برنامج يوم عمل لأستاذ مجتهد في الحوزة العلمية النجفية.
وتناول الفصل الخامس الموسوم (المرجع والمرجعية الدينية) في أربعة مباحث حديثا عن المرجع الديني وطرائق التحقق من توفر الشروط المطلوبة فيه، محددا المقصود بالمرجع الأعلم، فشارحا مسألة تعدد المراجع مع توضيح لمهمات المرجعية وإنجازاتها على أرض الواقع، مستعرضا برامج أيام عمل لبعض مراجع التقليد في حوزتها العريقة.
وتناول الفصل السادس الموسوم (أشهر مراجع التقليد في حوزة النجف الأشرف العلمية الحالية) في مباحث أربعة : السيرة الحياتية والعلمية لكل من أصحاب السماحة: المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني والمرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم والمرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض والمرجع الشيخ بشير النجفي.
بينما تناول الفصل السابع الموسوم (طلاب حوزة النجف الأشرف) في مباحث أربعة تبيانا لأعداد الطلاب التقريبية في الحوزة العلمية النجفية سابقا وحاليا، ثم تعريفا بأماكن الدراسة الحوزوية وبالأخص ما كان منها في المدارس الدينية سابقا وحاليا أيضا، ثم عرضا لبرنامج يوم عمل لطالبين مشتغلين من طلاب حوزة النجف الأشرف.
وتناول الفصل الثامن الموسوم (النظام الدراسي المتبع في حوزة النجف الأشرف بعض من إيجابياته وسلبياته) في مبحثين بعضا من إيجابيات النظام المتبع في حوزة
ص: 5
النجف الأشرف العلمية، ثم بعضا من سلبياته.
أما الفصل التاسع الموسوم (من مشاريع إصلاح المنهج الدراسي المتبع في مرحلتي المقدمات والسطوح في حوزة النجف الأشرف) فقد تناول في مبحثين تقاسمتهما مطالب أربعة بعضا من محاولات إصلاح المنهج الدراسي المتبع في مرحلتي المقدمات والسطوح سواء ما تضمن منها تأليف كتب دراسية جديدة لتحل محل الكتب القديمة أم إجراء تعديل على المنهج الدراسي المتبع فيهما.
بينما تناول الفصل العاشر الموسوم (تصنيف محاولات الإصلاح العام في حوزة النجف الأشرف) توصيفا عاما لمحاولات الإصلاح فيها، تجلية لأسسها النظرية، وتبيانا لمنطلقاتها الفكرية، وتحديدا لآلياتها التطبيقية.
في حين تناول الفصل الحادي عشر الموسوم (مشاريع إصلاحية لم تنجز كما أريد لها أن تنجز) في مبحثين مشاريع تطوير وإصلاح النظام السائد في الحوزة، تعرض أولهما لمشروع نظام مدرسة كاشف الغطاء العلمية، وتطرق ثانيهما إلى مشروع نظام مدرسة دار العلم للسيد الخوئي (قدّس سِرُّه).
أما الفصل الثاني عشر الموسوم (مشاريع إصلاحية تحققت على أرض الواقع، جمعية منتدى النشر أنموذجا) فتحدث في مبحثين عن هذه الجمعية الرائدة شارحا أولهما بواكير مشروع المنتدى الإصلاحي وصعوباته ومعوقاته، ومعرفا ثانيهما بشيء من التفصيل لبرنامج منتدى النشر الإصلاحي وما نهضت به هذه الجمعية من أعمال وما راودتها من آمال ثم ما تحملته جراء ذلك من مصاعب ومصائب.
بينما تناول الفصل الثالث عشر الموسوم (من جديد أنظمة حوزة النجف الأشرف) ما تبنته الحوزة العلمية من نظام جديد بما فيه من اتباع آلية الامتحانات سعيا لتحديد
ص: 6
المستوى العلمي للطالب الحوزوي وما يترتب على ذلك من مستحقاته تبعا لمستوى تحصيله الدراسي متضمنا إحصائيات تفصيلية لأعداد كل مرحلة دراسية ونتائج طلبتها منذ أن شرعت حتى آخر امتحان تحريري أجري لطلبتها وظهرت نتائجه قبل دفع هذه الطبعة إلى المطبعة بفترة ليست طويلة مشفوعة بقراءة إحصائية لها في الملاحق.
ثم تناول الفصل الرابع عشر الموسوم (مشاريع تطويرية قائمة على أرض الواقع حاليا) فقد تعرض في مباحث ثلاثة لنظام ثلاث مدارس حوزوية قائمة اليوم هي : مدرسة الإمام الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) للطلاب، ومدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية بقسميها، ومدرسة دار العلم النسوية موضحا نظام كل من المدارس الثلاث ومناهجها الدراسية وآليات وطرائق التدريس فيها وما إلى ذلك من بعض شؤونها الأخرى.
أما الفصل الخامس عشر الموسوم (هيئات ومؤسسات علمية وإرشادية) فتناول في مبحثين هما: (الهيئة العلمية لمؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي، ومؤسسة المصطفى للإرشاد والتوعية الدينية أنموذجا) معرفا أولهما في مطلبيه بالهيئة العلمية وما ضمته من تشكيلات إدارية وتنظيمية مع تبيان لنشاطاتها الاجمالية، وعرف ثانيهما في مطلبيه بمؤسسة المصطفى للإرشاد والتوعية الدينية من حيث دواعي التأسيس والأقسام.
ثم تناول الفصل السادس عشر الموسوم (مؤسسات معارف إسلامية مؤسسة الشيخ زين الدين (قدّس سِرُّه) هل للمعارف الإسلامية أنموذجا) فقد تقاسمته مباحث ثلاثة تناول المبحث الأول منها أهداف المؤسسة وآلية تنفيذها، وتناول المبحث الثاني منها : نظامها العام، فيما تناول المبحث الثالث نشاطاتها المتعددة.
في حين تقاسم الفصل السابع عشر منها الموسوم (مؤسسات معنية بالمخطوطات
ص: 7
والوثائق (مؤسسة كاشف الغطاء العامة أنموذجا) مبحثان، تناول المبحث الأول منهما: تاريخ تأسيسها، وتناول المبحث الثاني منهما أقسام المؤسسة المعنية بشاطاتها الأساسية.
وأتبعت فصول الكتاب المتقدمة بخائمة اتبعتها بملاحق إحصائية أو توضيحية أو توثيقية لبعض ما ورد في فصول الكتاب وشؤونه.
ويحسن بي أن أضيف هنا بأني كنت خصصت الفصل الثامن عشر الموسوم ب(مقترحات عامة لإصلاح النظام القائم في حوزة النجف الأشرف) المتكوِّن من مبحثين، تمحَّض أولهما لتبيان أفكار عامة لإصلاح الحوزة العلمية النجفية ارتأيت - حسب قناعتي - أن نظامها القائم اليوم يحتاجها حاجة ماسة، في حين تخصص ثانيهما بوضع مشروع مقترح لنظام أساتذة الحوزة العلمية النجفية اشتمل على مواد مفصلة، معتقدا أن هذه المقترحات كفيلة - إلى حد معقول - بتحصينها من خلال آليات محددة، تقطع الطريق على دعاوى المدّعين من حيازتهم على درجاتها العلمية الرصينة، دون وجه حق من جهة، وتفعيل دورها أكثر فأكثر لتلبية احتياجات الأمة المؤمنة من جهة ثانية.
بيد أني أعرضت عن نشره مؤقتا، لحين توفر الظرف المناسب له.
ويشرفني أن أقول هنا بأني عكفت لاحقا على تطوير وتحديث مسودة الفصل الثامن عشر المشار اليه أعلاه، فترة ناهزت السنة انتهت به إلى أن يكون كتابا تفصيليا يتضمن برنامجا واسعا لتحديث وتطوير نظام حوزة النجف الأشرف، ورفده بخطط عمل جديدة، وأنساق تطوير حديثة، وآليات تنفيذية محددة، أخال أنها كفيلة بأن تنهض به إلى واقع أفضل من خلال أربعة فصول، ومقدمة، وخاتمة، ملحوقة بعرض لمصادر الكتاب ومراجعه.
ثم آليت على نفسي ألّا أنشره قبل أن أعرض مسودته على أكثر من مكتب من
ص: 8
مكاتب مراجع التقليد في حوزة النجف الأشرف الحالية، ليقيني بأنّ أي تحديث لنظام حوزة النجف الأشرف، لا تتبناه المرجعية، أو تدعمه، أو ترضى به، أو لا تعارضه، من الصعب أن يكتب له النجاح، في حوزة علمية، هي زعيمتها، عسى أن أوفق لنشره في الوقت المناسب إن شاء اللّه.
وسيكون الكتاب في حال صدوره هو الكتاب الخامس من خماسية عن حوزة النجف الأشرف أكاد أنتهي من تأليفها الآن تعنون كتابها الأول بعنوان (الحوزة ونجفها معالم المكان البيئة العربية الحاضنة تبادل التأثر والتأثير بين البيئة وحوزتها) وتعنون كتابها الثاني بعنوان (البحث الفقهي / الأصولي عصوره العلمية ومراجعه المعاصرون) وتعنون كتابها الثالث بعنوان (النظام الدراسي المتّبع مراحله ومناهجه، طلابه ومدارسه إيجابياته وسلبياته)، وتعنون كتابها الرابع بعنوان (مشاريع تطوير النظام الدراسي في حوزة النجف الأشرف) إضافة إلى الكتاب الخامس الذي تقدم ذكر موضوعه سابقا.
ويحسن بي أن أذكر هنا أن الطبعة الثالثة اشتملت على تحديث لبعض ما ورد في الطبعة الثانية وإضافات مع تصحيح لبعض من الأخطاء الطباعية
أسأل اللّه أن يتقبل عملي بقبوله الحسن الجميل، وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى اللّه بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك على كل شيء قدير والحمد للّه رب العالمين.
المؤلف
النجف الأشرف
النصف الثاني من عام
1433ه- / 2012م
ص: 9
ص: 10
يحسن بي أن أمهد لبحثي عن حوزة النجف الأشرف بتعريف موجز بالمرقد العلوي الشريف الذي لولاه لم تكن الحوزة النجف الأشرف أن تكون حوزة، بل لم تكن أرض النجف حاضرة علمية لنجف أشرف.
تشرفت أرض النجف الأشرف باحتضان العديد من المعالم المقدسة والأماكن التاريخية والأثرية والمقامات والمساجد ودور العبادة وغيرها الكثير.
بيد أن معلمها المقدس الأهم والأشرف هو الحرم العلوي المطهر، الذي ضم بين جنباته جدث أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام العادل علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فقصده - للتشرف بمجاورة باب مدينة علم رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)، وأقضى صحابته - العلماء الأعلام: سواء أكانوا حفظة ومفسرين، أم فقهاء ومحدثين، أم باحثين ومحققين، أم فلاسفة ومتكلمين، أم شعراء ومبدعين، أم غيرهم من أرباب صنوف المعارف الإسلامية الأخرى، فكانت حاضرة النجف الأشرف منذ أن ألقى عصا الترحال فيها السادة العلويون، وأقام فيها ثاويا مستوطناً الأحباب الموالون، فنشأت حوزة النجف الأشرف العلمية وشيدت أعرق وأغنى حاضرة لمعارف أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) منذ ألف عام.
وقبل ذلك وبعده، فقد يمم شطر مرقده المقدس (عَلَيهِ السَّلَامُ) الملايين من الزوار على مر
ص: 11
السنيين، لما للزيارة عند المسلمين وغيرهم، وعند الشيعة بالأخص من حضور روحي محبب تفيض خلاله الروحانية الكبرى للمزور على الزائر، وتغمر فيه المبدئية والصفات القدسية للإمام العادل نفسية الميمم القاصد، فتكتسب من روحانيته ما تكتسب، وتنهل من مبدئيته الصافية ما تنهل، فتطمئن بعد اضطراب، وتصفو بعد كدر، وتسعد بعد شقاء، وترجو بعد قنوط وتشرق بعد تجهم، وربما يحصل ذلك الإنعاش الروحي بمجرد تصور صفاء روح المزور، وتذكّر قيمه ومبادئه الحقة في طواف حول المزور طوافا ذهنيا محضا دون خصوصية للمكان.
ولكن محبي الأئمة الأطهار لا يكتفون بذلك، بل لا تعد الزيارة الروحية زيارة إلاّ إذا كانت عند تربة المزور وبحضرته، ويركزون عملهم هذا على ركيزتين :
إحداهما: قوله تعالى «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّه أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللّه مِن فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّه وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّه لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ»(1).
فهم يعتقدون أن أرواح المؤمنين لها الحياة ولها الخلود فهي لا تموت ولا تتلاشى.
وثانيهما: إن بين الروح والجسد اتصالا وارتباطا وثيقا، فهما متصلان منفصلان، وان للروح على تربة المتوفى انعكاسا مثل الزجاجة،والنور، فروح ذلك العظيم متصلة بمشهده، ومن يحظ بذلك المشهد يدركها إدراكا روحيا، فيحظى ببعض تلك الأضواء، ثم يرجع إلى أهله وفي نفسه قبس من النور المقدس.
هذه هي الزيارة، وذلك هو الموسم(2).
ص: 12
خط المرقد العلوي الشريف لأمير المؤمنين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) سنة أربعين للهجرة الشريفة، وقد سوَّى ولداه الإمامان الحسن والحسين (عَلَيهِم السَّلَامُ) سيدا شباب أهل الجنة قبره مع الأرض وأخفيا معالم الجدث بوصية منه (عَلَيهِ السَّلَامُ) اليهما، وهو على ما يقول المؤرخ الجاحظ: أول إمام خفي قبره.
وبقي موضع خط المرقد العلوي سرا مكتوما لا يعرفه إلّا أهل بيته والخاصة من صحبه والصالحين من أتباعه لأسباب عديدة منها كما يبدو : جرأة أعدائه الظلمة على نبش قبره (عَلَيهِ السَّلَامُ) حتى قيل إن الحجاج بن يوسف الثقفي حاول جهده الاهتداء لموضع القبر الشريف فحفر لذلك ثلاثة آلاف قبر في النجف طلبا له، ولم يعثر له على أثر (1).
أما الخاصة من أهل بيته والخلص من أتباعه فكانوا يتعاهدونه بالزيارة والسلام بعيدا عن أعين الرقباء.
وذكر قسم من المؤرخين أن المنصور العباسي حين علم أنّ الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعددا من أصحابه يوالون زيارة القبر، وكان الخليفة كغيره من عامّة الناس يجهل موضعه، أراد أن يتأكد من ذلك بنفسه، فذهب منفرداً مع بعض خاصته وخَدمه وأمر أن يحفر في المكان المحدد للقبر، وكان يزوره بعد ذلك يناجيه معتذرا إليه مما يفعله بأبنائه.
وذكروا: إنّ داود بن علي العباسي أيضا فعل ذلك، فشاهد كرامة باهرة أخافته، فأمر ببناء القبر وصنع صندوقاً وضعه عليه عام ( 133 ه- / 750م) وجعل عليه صندوقا خشبيا برهة من الزمن ثم أزاله (2).
وفي عهد هارون وقد خرج للصيد في هذه المنطقة كما سيأتي رأى كرامة حملته على أنّ ينعطف ويخشع.
ص: 13
ما ان أشهر الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) موضع المرقد الشريف بعد زوال دولة بني أمية من خلال بناء دكّة عليه كما روى بعضهم، حتى تعاضدت على تشييد عمارته أيدي المسلمين والمؤمنين والأخيار الصالحين.
وقد اختلف المؤرخون في زمن تشيّد العمائر المتقدمة على مرقد أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) ومن شيدها، كما اختلفوا في عدد هذه العمائر، فقد أوصلتها مؤلفة كتاب (مشهد الإمام علي) إلى سبع عمائر (1)، في حين ذهب الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي إلى أنها ست عمائر(2)، وأشار الباحث محمد علي التميمي إلى أنها خمس عمائر(3)، وهو ما ذهب اليه الشيخ جعفر محبوبه(4) ولعله الأرجح.
وهذه العمائر الخمس هي :
ذكر العديد من المؤرخين خلافا لما ورد من أن الإمام علي بن الحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) أمر صفوان الجمال بوضع أول بنية على القبر الشريف، وخلافا لما تقدم عن وضع داود بن علي العباسي صندوقا على القبر - أن أول عمارة على القبر الشريف أقيمت في عهد الخليفة هارون العباسي (149 - 193 ه/ 766-808م) بوضع بنيان بآجر أبيض، وهي على هذا القول العمارة الأولى للحرم العلوي المطهر.
فقد ذكر القندوزي في (ينابيع المودَّة) : لم يزل قبر علي رضي اللّه عنه مختفياً إلى زمن هارون، ثم ظهر بالغري بظاهر الكوفة، ويزوره إلى اليوم الناس، وصار قبره مأوى كل لهيف وملجأ كل هارب.
وقد اختلف المؤرخون في تاريخ إقامة هذه العمارة، فقد ذهب صاحب (رياض
ص: 14
السياحة) إلى أنها بنيت سنة (155 ه / 772م)، فيما جاء في (عمدة الطالب) و(نزهة القلوب) أنها بنيت سنة (170 ه / 786م)، بينما ذكر صاحب (نزهة الغري) أنها بنيت سنة (175ه/ 791م)، وهو ضعيف لتولي هارون الخلافة ما بين الأعوام (170 198ه / 786 م 791م)، وتظل الروايات الأخيرة محل نقاش كبير.
ويبدو أن هذه العمارة على فرض وجودها اندرست بعد عشرات السنين، بسبب الضغوط الكبيرة التي كان يمارسها العباسيون على مراقد العلويين، وعدم السماح لهم بصيانة أو ترميم المرقد الطاهر الأمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).
المعروف بالداعي صاحب طبرستان(1). فقد ذكر ابن طاووس أن محمد بن زيد هو الذي بنى المشهد الشريف الغروي، أيام المعتضد، وقتل في وقعة أصحاب السكان، وقبره بجرجان (2).
وربما تنسب هذه العمارة إلى أخيه الحسن، ولعل سبب هذا اللبس ما اشار اليه الشيخ الطوسي في التهذيب من أن الحسن بن زيد بنى حائطاً كسور يحيط بالمشهد العلوي.
وقد أنشئت هذه العمارة في زمن المعتضد بالله العباسي (279 289ه / 892 -902م) (3).
يعد السلطان عضد الدولة البويهي أحد تلامذة الشيخ المفيد، وقد أنشأ هذه العمارة (سنة 369ه / 979م)، واستمر العمل على تشييدها حتى (سنة 371ه/ 981م).
ص: 15
ولقد كانت هذه العمارة من أفضل العمارات المشيدة في حينها، وأحسنها وأجملها وأكبرها، وهي على شكل ضريح مربع تعلوه قبة عظيمة، فبعد أن دخل البويهيون إلى العراق، أمر عضد الدولة البويهي ببناء عمارة جديدة بدلاً من العمارة القديمة، وبذل الأموال الطائلة لتشييدها، جالبا لها من بغداد العصر الذهبي خيرة المهندسين والمصممين والمعماريين والبنَّائين وذوي الفن والصنعة في دولته، ثم أحضر مواد البناء من صخور وأخشاب وغيرها من أماكنها النائية حيث ما وجدت، وحين أعوزه الطابوق والجصّ لعمارته الشاهقة بنى لها قريبا من بئر معروف في بادية النجف مصاهر لما يحتاجه منها، كما حفر قناة للماء من نهر الفرات في الكوفة إلى حيث النجف الأشرف، ثم أقام رواقا مرتفعا عقد عليه قبة بيضاء زاهية.
وقد ذكر هذه العمارة الرحالة ابن بطوطة، عندما زار مدينة النجف الأشرف (سنة 727ه- / 1327م)، ووصفها وصفاً مفصَّلاً فقال : ثم باب الحضرة حيث القبر... وبإزائه المدارس والزوايا والخوانق معمورة أحسن عمارة، وحيطانها بالقاشاني، وهو شبه الزليج عندنا، ولكن لونه أشرق، ونقشه أحسن، وإذا ما دخل زائر يأمرونه بتقبيل العتبة، وهي من الفضّة، وكذلك العضادتان، ثمّ يدخل بعد ذلك إلى القبة، وهي مفروشة بأنواع البسط من الحرير وسواه، وبها قناديل الذهب والفضة منها الكبار والصغار، وفي وسط القبة مسطبة مربعة، مكسوّة بالخشب، عليها صفائح الذهب المنقوشة المُحكمة العمل، مسمّرة بمسامير الفضة، قد غلبت على الخشب، لا يظهر منه شيء، وارتفاعها دون القامة، وفوقها ثلاثة من القبور، يزعمون أن أحدها قبر آدم (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والثاني قبر نوح (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والثالث قبر الإمام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ). وبين القبور طشوت ذهب وفضة، فيها ماء الورد والمسك، وأنواع الطِيِب، يغمس الزائر يده في ذلك، ويدهن بها وجهه تبرّكاً.
وللقبة باب آخر، عتبته أيضاً من الفضّة، وعليه ستور الحرير الملوّن، يفضي إلى
ص: 16
مسجد مفروش بالبسط الحسان مستورة حيطانه وسقفه بستور الحرير، وله أربع أبواب عتبتها،فضة، وعليه سور الحرير وخزانة الروضة العظيمة فيها من الأموال ما لا يضبط لكثرته.
وقد عقد عضد الدولة في بهو الحرم المطهر وتحت رواقه البهي مهرجان افتتاح عمارته الفخمة، داعيا اليه الأمراء والعلماء والنقباء والوجهاء والشعراء والأدباء، وكان من بينهم الفقيه الشاعر الشريف المرتضى، يومها دخل عضد الدولة الحضرة الشريفة وقبل أعتابها وأحسن الأدب، ثم ألقى الشاعر الحسين بن الحجاج قصيدته المعروفة في ذلك البهو الزاهي بمطلعها المشهور :
ياصاحب القبة البيضا على النجف***من زار قبرك واستشفى لديك شفي
وهي العمارة التي تمت في (سنة 760 ه/ 1385م) ونفَّذها أكثر من سلطان من السلاطين، حيث لم تقتصر عمارتها على واحد بعينه منهم كي تسمى باسمه، والمرجح أنها تمت على أيدي الإيليخانيين.
وهي العمارة القائمة اليوم، وتدعى بالعمارة الصفوية، وقد شيدت هذه العمارة كما يبدو على مرحلتين : أولاهما في (سنة 1033ه- 1623م)، يوم زار الشاه عباس الصفوي الأول العتبة العلوية الشريفة قادما اليها من طريق الحلة، فلما أن صار موكبه على مرحلة من واديالسلام، ولاحت لعينيه القبة المنورة، نزل عن ركابه وجعل يمشي حافيا على قدميه، وهو حامل تاجه بين يديه، ونزل معه جميع وزرائه وأمرائه وعساكره حتى دخول الحرم الأقدس، وبقي في جوار حرم أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) عشرة أيام، وكان
ص: 17
يقضي أكثر أوقاته في الزيارة والدعاء والابتهال، وقد جعل نفسه أحد الخدم الذين يخدمون ذلك الحرم الشريف، وكان يتولى كنس الحرم من الغبار بيده في كل يوم من أيام إقامته في النجف (1) الأشرف.
وقد أمر بإيصال الماء إلى الروضة المطهرة، كما أمر بتجديد القبة المطهرة، وتوسيع بناء الحرم العلوي، وجلب لذلك المهندسين المهرة والمعماريين البارعين والبنائين المتميزين من أهل الخبرة والجودة والفن.
وثاني المرحلتين وهي الأهم كان في (سنة 1042 ه / 1631م) يوم زار الضريح المقدس حفيد الشاه عباس الصفوي الأول، وهو الشاه صفي بن صفي ميرزا بن السلطان شاه عباس الصفوي، فأمر وزيره ميرزا تقي خان بتجديد القبة المرتضوية، وفسحة الحرم، وتوسعته.
بيد أن أهم تجديد للعمارة الصفوية هو ما قام به السلطان نادر شاه، فإذ زار مدينة النجف الأشرف في (سنة 1156 ه / 1743م وقيل سنة 1155 ه / 1742م) ووجد القبة المشرفة خلوا من التذهيب أمر بأن تكسى القبة الموقرة بالإبريز (الذهب الخالص)، وأمر كذلك بأن تكسى المئذنتان والإيوان أيضا، وأن تطلى الكتابة الممنطقة للقبة من داخلها بالميناء والفسيفساء (2)، وقد ثبت التأريخ الهجري لتذهيب القبة والروضة وهو (سنة 1156 ه / 1742م) كتابة بالحروف الذهبية على جبهة الإيوان الزاهي.
تتميز العمارة الصفوية، بل تنفرد بميزات علمية لم تتحقق لغيرها من المباني القديمة أو الحديثة، ولا توجد في أية عمارة أثرية في العالم (3) فقد صمم مهندسها المعماري الجدار الشرقي للصحن الحيدري الشريف ليكون بمثابة شاخص لتعيين وقت الزوال على
ص: 18
مدى فصول السنة، وهذه الظاهرة موجودة في مكانين في هذا الجدار :
الأول: توجد ثلاثة أقواس من القاشاني الأزرق الملتوي تحت الساعة على واجهة باب الإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) المعروف بباب السوق الكبير، وعندما تصل الشمس إلى منتصف القوس الأوسط منها يكون وقت الزوال
الثاني: الأواوين الأربعة التي بين باب مسلم بن عقيل (عَلَيهِ السَّلَامُ) المعروف بباب العبايجية والزاوية الشمالية الشرقية، ففي الوقت الذي تصعد فيه الشمس إلى أرض هذه الأواوين بعرض أربعة أصابع من حافتها يكون وقت الزوال في جميع فصول السنة (1) قد حل.
ولم يكتف المصمم المعماري بذلك، بل أضاف اليه إبداعا علميا آخر، ذلك أنه في كل يوم عند شروق الشمس وغروبها، وفي جميع فصول السنة تنفذ أشعة الشمس عند بزوغها إلى داخل الحرم المطهر من الشباك الشرقي الذي يقع في أسفل القبة الشريفة، وفي ساعة غروب الشمس تغرب بخروج حزمة من أشعتها من داخل الحرم المطهر من الشباك الغربي الذي يقع في أسفل القبة الشريفة (2).
يقول الشيخ محمد حسين حرز الدين (3): ويلاحظ أن في وضع الباب الكبير بمكانه هذا هو جعل بزوغ الشمس في الضريح الأقدس طيلة فصول السنة الأربعة، بحيث لو أن شخصا وقف عند القبر الشريف جانب الرجلين يرى أول بزوغ الشمس من خلال الباب الكبير الشرقي والسوق الكبير وباب البلد الشرقي الرئيسي في سور المدينة على مدى أيام السنة. هذا يوم كانت النجف مسورة والجانب الشرقي منها مكشوف ولم تكن عمائر ولا أحياء جديدة ولا أشجار تحجب بزوغ الشمس ونتيجة لتوالي العمائر في الجهة الشرقية فقد انعدمت رؤية الشمس حين بزوغها وقد أشير إلى بزوغ الشمس ببيت من الشعر الفارسي كتب بالقاشاني في داخل الثلث الأعلى لطاق
ص: 19
باب الصحن الشرقي الكبير من جانب الصحن بحروف كبيرة زرقاء داكنة على أرضية صفراء ومعناه أعظِم بأن الشمس تضع جبهتها كل صباح على تراب عتبة قبرك الطاهر.
وإذ وصل بي البحث إلى هذا الموضع، فإني لأرجو من مهندسي العتبة الحيدرية المطهرة وأمنائها أن يعلَّموا هذه الإبداعات العلمية الهندسية بإشارات دالة عليها، بحيث تلفت نظر الزائر والباحث والمستطلع، وأن يزيلوا العوائق التي تحجب رؤية هذا الإعجاز الهندسي الرائع لكل ذي عينين.
يعدّ الحرم العلوي المطهر بعمارته البهية الحاضرة أبرز معلم من معالم مدينة النجف الأشرف، ويقع وسط مدينتها القديمة تماما، متخذا شكلا دائريا أو بيضويا، مكونا بمركزيته القطب الشامخ الذي دارت حوله مكونات المدينة، فهو العنصر المؤثر في تكوينها وظيفيا وبصريا، بمساحته البالغة هكتارا ونصف الهكتار بما يقارب نسبة 2% من مساحة المركز التأريخي للنجف التقليدية (1).
وتضم العمارة الحالية للحرم العلوي (ينظر الملحق الأول) الصحن الشريف والروضة الحيدرية المطهرة بقبتيها الداخلية والخارجية ومئذنتيها المذهبتين وخزائنها النادرة، ومكتبتها العامرة، وملحقات أخرى عديدة سآتي على وصفها والتعريف بها مفصلا في كتابي: (حوزة النجف الأشرف الكتاب الأول، الحوزة ونجفها، معالم المكان، البيئة العربية الحاضنة، تبادل التأثر والتأثير بين البيئة وحوزتها) الذي آمل أن يصدر هو والكتب الأربعة الأخرى من (خماسية حوزة النجف الأشرف) خلال هذا العام إن شاء اللّه.
ص: 20
(1) سورة آل عمران: الآيات 169 - 171.
(2) الأحلام. الشيخ علي الشرقي: 145.
(3) ينظر: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني : 2 / 53.
(4) ينظر : تاريخ النجف الأشرف. الشيخ محمد حسين حرز الدين: 2/ 55.
(5) مشهد الإمام علي، سعاد ماهر 129 136
(6) دليل النجف الأشرف، عبد الهادي الفضلي 24
(7) ينظر مشهد الإمام محمد علي التميمي: 199:1
(8) ماضي النجف وحاضرها، جعفر محبوبه 41:1 48
(9) مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني 445
(10) فرحة الغري ابن طاووس 110
(11) المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكل على اللّه
(12) تاريخ النجف الأشرف : 287.
(13) الأحلام. سابق: 176.
(14) مرقد وضريح أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ). د. صلاح الفرطوسي : 231
(15) مساجد ومعالم في الروضة الحيدرية المطهرة. السيد عبد المطلب الموسوي الخرسان: 13 وينظر: ماضي النجف وحاضرها: سابق: 51/1، مرقد وضريح أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ). سابق : 231
(16) تاريخ النجف الأشرف. سابق : 1/ 37. والمصدر السابق: 14
(17) المصدر السابق : 1/ 373
ص: 21
(18) دراسة تحليلية تخطيطية للمحافظة على المركز التاريخي والحضاري لمدينة النجف الأشرف. د. المهندس حيدر عبد الرزاق كمونة. بحث. النجف الأشرف عاصمة الثقافة الإسلامية وكنز المعارف والعلوم. مركز دراسات الكوفة. جامعة الكوفة : 6/2
ص: 22
الحوزة مصطلحاً، وتاريخاً علمياً موجزاً
ويتضمن هذا الفصل مبحثين هما :
المبحث الأول : مصطلح الحوزة العلمية.
المبحث الثاني: موجز من تاريخ حوزة النجف الأشرف العلمي.
ص: 23
ص: 24
يحسن بي أن أبدأ حديثي بتحديد مصطلح (الحوزة العلمية) بعد أن تداولته وسائل الإعلام المختلفة وفسرته بعضها عن قصد أو بدونه على هواها، وبخاصة إثر بروز مدينة النجف الأشرف ومرجعيتها الدينية كصانعة الحدث كبير في العراق، وحاضرة حضورا فعليا خارجه مما لا يمكن تجاوزها أو تخطيها بحال من الأحوال.
تعدّ الحوزة العلمية الوسط العلمي المنتج والحاضن معاً للساعين إلى الخروج من عهدة التكليف الإلهي بالنفر الوارد في قوله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد : «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (1) من الباذلين جهدهم للتخلق بأخلاق الإسلام وآدابه سواء أكانوا علماء ومبلغين أم معلمين ومتعلمين أم مفسرين ومؤرخين أم من غيرهم من السالكين إلى اللّه والداعين اليه، خطباء كانوا أم وكلاء أم مبلغين أم من حذا حذوهم واقتدى بسنتهم، متفقها في الدين تارة، ومنذرا ومبلغا أخرى، متأدبا بآداب الإسلام الكريمة وأخلاقه السامية.
والحوزة العلمية في الوقت نفسه ذراع المرجعية والوجود الرابط أو الحلقة الموصلة بين المرجع الديني المجتهد ومقلِّده، والحكم الشرعي ومتّبعه، والعالم بأصول الشريعة وفروعها والمتعلم.
ص: 25
وهي تعني أيضا فيما تعنيه: مركز التعليم الديني الذي يتبع في طريقة تعليمه النهج الذي تربى عليه الفقهاء السابقون منذ العصور الإسلامية الزاهرة وحتى العصر الحاضر، متخذة من نظام الحلقات في الغالب شكلاً لها، متبعة نظام الدراسة التامة بأن يبحث الموضوع ثم يعاد بحثه في كتب لاحقة متعاقبة مع توسعة متدرجة، متخذة من شرح عبارة الكتاب المقرر وتحليلها والغوص في مداليلها ومعانيها طريقة للتدريس، متيحة للطالب الحرية المطلقة في المناقشة مانحة إياه الفرصة المثلى لاختيار الأستاذ الذي يشاء، وتحديد الزمان والمكان للدرس بالاتفاق بينهما عليه، ساعياً طالبها من وراء دراسته نيل رضا اللّه عز وجل في دنياه وآخرته مبتغيا تحصيل المعارف الشرعية زاهدا بملذات الدنيا الفانية وزخارفها، أو هكذا هو المفترض بالحوزوي، بيد أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال صدق انطباق عنوان نية القربة اللّه عز وجل والإخلاص والواقعية والتجرد والزهد واستفراغ الوسع في البحث والدراسة والعلم والعمل على جميع الحوزويين طلاباً وغير طلاب.
ص: 26
لئن اختلف المؤرخون في تحديد أوائل العمر الزمني الناضج للحركة العلمية الدينية في النجف الأشرف، فإنهم يتفقون أيا كانت آراؤهم على أن مدينة النجف الجامعة كانت حاضرة للعلم وحاضنة له، يؤمها الطلاب ويقصدها المتعلمون للتزود بالعلم والمعرفة والبحث والتحقيق بعد (سنة 448ه / 1056م) زمن هجرة شيخ الطائفة وصاحب كرسي الكلام وأحد الرواد الأوائل لعلم الفقه المقارن ومؤلف الكتب الثمانين في الفقه والتفسير والأصول والرجال وغيرها الشيخ محمد بن الحسن الطوسي(1) المتوفى (سنة 460 ه- / 1068م) وانتقاله شبه القسري من بغداد إلى النجف الأشرف إثر اقتحام داره وإحراق كتبه ابان فتنة طائفية بين المسلمين شيعة وسنة، أشعلها وأورى زنادها ببغداد حاكمها طغرل بك السلجوقي أول دخوله البغداد، فاختلطت جراء فتنته الطائفية دماء أبناء بغداد ومداد حبرهم وعقلانية أفكارهم كلها في شوارعها وأزقتها ونهر دجلتها التي مزج ماؤها بين حمرة الدم القاني وسواد مداد الكتب مما ألقي فيها منها، وقد ادى التعصب الطائفي المقيت إلى إحراق أعظم مكتبة إسلامية شيعية يومها هي مكتبة (دار العلم) التي ضمت بين دفتيها وفوق رفوفها أكثر من عشرة آلاف مجلد في مختلف العلوم والآداب والفنون بعد جلبها بمشقة وتعب من مختلف الأقطار والبلدان حتى وصفها المؤرخ والجغرافي المعروف ياقوت الحموي (2) بقوله لم يكن في الدنيا أحسن كتبا منها، كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة و أصولهم المحررة.
ص: 27
كما أدى الهجوم الوحشي الطائفي على دار الشيخ الطوسي ببغداد إلى إحراق كرسيه، كرسي الكلام الذي لا يتبوؤه في العادة إلّا الباحث الأعلم من بين علماء عصره الكثر، ولم يكتف المتعصبون بذلك، ولم يشف غليلهم ما سفكوه من دماء ولا ما بعثروه من أشلاء، بل عمدوا زيادة في الإيذاء وإمعانا في محاربة الرأي الآخر إلى حرق ونهب تصانيف الشيخ الطوسي الكثيرة وإشعال النار في مكتبته العامرة.
إن هجرة الشيخ الطوسي القسرية من بيته العامر بكرخ بغداد إلى مثوى الإمام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في النجف الأشرف وما تبعها من انتظام الدراسة على شكل حلقات للبحث والتدريس ومن إملاء شيخ الطائفة لدروسه جوار قبر أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وما نتج عن تلك الحلقات الدراسية من معارف جمة ثم ما ضمه كتاباه المهمان: (اختيار الرجال) في علم الرجال الذي بدأ بإملائه على تلامذته في النجف الأشرف ابتداء من (سنة 456 ه/ 1064م)، و (شرح الشرح) في علم أصول الفقه وغير ذلك من إبداعات شيخ الطائفة العلمية والفكرية المتنوعة، شكلت بمجموعها البداية الأكثر نضجا لتأسيس جامعة النجف الأشرف الدينية (1) حيث أصبحت الحوزة العلمية الفتية في النجف تربو على المئات من رواد الفضيلة والعلم والطلبة الناشئين والمؤلفة على حد رأي بعض المصادر من أولاده وبعض اصحابه ومجاوري القبر الشريف وأبناء البلاد القريبة منها كالحلة ونحوها، وبرز فيها العنصر المشهدي نسبة إلى المشهد العلوي والعنصر الحلي وتسرب التيار العلمي منها إلى الحلة(2) كما ذكر تاريخيا أن هذا الشيخ العظيم خرّج من تحت كرسي درسه أكثر من ثلاثمائة مجتهد. (3).
ولم يترك شيخ الطائفة الطوسي حوزة نجفه إلّا وعليها أبرز تلامذته ولده الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الذي خلف أباه على العلم والعمل وتقدم على العلماء في النجف وكانت الرحلة اليه والمعول عليه في التدريس والفتيا وإلقاء الحديث وغير
ص: 28
ذلك وكان من مشاهير رجال العلم وكبار رواة الحديث وثقاتهم. وقد بلغ من علوّ الشأن وسموّ المكانة أن لقب بالمفيد الثاني(1).
يقول ابن حجر (2) ثم صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد علي رضي اللّه عنه وهو في نفسه صدوق مات في حدود الخمسمائة وكان متدينا مشهودا له بالفقه والحديث والرجال واليه تنتهي أكثر الإجازات عن شيخ الطائفة الطوسي كما كان حريصا على إتمام مهمة أبيه الشيخ في رعاية حوزتها الناشئة وتنظيم مناهجها الدراسية وتنشئة جيل من العلماء العاملين والمبلغين من الخاصة والعامة عدّ منهم الشيخ منتجب الدين بن بابويه أربعة عشر رجلا وأضاف الشيخ أغا بزرك الطهراني ستة عشر شخصا كما ذكر ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ثلاثة أشخاص من العامة فيكون المجموع أربعة وثلاثين شخصا(3).
لقد خلف لنا الشيخ أبو علي كتابا نافعا أسماه (شرح النهاية) هو شرح لكتاب والده شيخ الطائفة الموسوم ب (النهاية) في علم الفقه.
وما أن انتقل الشيخ ابن الشيخ إلى لقاء ربه راضيا مطمئنا حتى تولى الأمر من بعده ولده الشيخ محمد بن الحسن بن أبي علي بن أبي جعفر الطوسي(4) فكان في النجف الأشرف بعد أبيه وجده شيخ الشيعة وعالمهم وابن شيخهم وعالمهم رحلت اليه طوائف الشيعة من كل جانب إلى العراق وحملوا اليه وكان ورعا عالما كثير الزهد أثنى عليه السمعاني.
وقال العماد الطبري : لو جازت على غير الأنبياء صلاة صليت عليه(5) فشهدت النجف وحوزتها بوجوده نشاطا علميا ملحوظا حيث تخرج على يديه كثير من حملة العلم والحديث من الفريقين ثم حين قيض له اللّه أن يرحل عن هذه الدنيا الفانية
ص: 29
ليلتحق بجده وأبيه في (سنة 540ه / 1145م) على الأغلب خلّف عليها الشيخ عماد الدين الطبري تلميذ أبيه وأحرص الفقهاء الثقاة على حوزة النجف وأكثرهم قابلية وأكفؤهم قدرة على النهوض بمهامها وتحمل مشاق إدارتها.
ولقد أرخ رئيس المجمع العلمي العراقي العلامة الشيخ محمد رضا الشبيبي(1) المتوفى سنة (1385 ه / 1965م) للنجف الجامعة فقال: مازالت النجف من أكبر عواصم العلم للشيعة وهي أكبرها منذ نحو قرنين، وما انفكت من أول ما خططت مأوى كثير من فقهاء الشيعة ومتصوفيهم وزهادهم، وما عبر عليها عصر خلت فيه من عالم أو أديب، غير أن لها عصورا معروفة حج اليها الناس فيها من أجل التعلم والتفقه، ورأس على رأس كل عصر منها إمام واحد أو أكثر من مشاهير أئمة الشيعة أقدمها عصر أبي جعفر الطوسي على إثر هجرته إلى النجف الأشرف وإقرائه فيها الناس وشدّهم الرحال اليه في منتصف القرن الخامس. ثم عصر عماد الدين الطبري النجفي تلميذ أبي على الطوسى في منتصف القرن السادس(2)، وفي هذا العصر زاحمت الحلة السيفية النجف من الجهة العلمية وصارت اليها رحلة الشيعة نحو ثلاثة قرون، ففتر الناس عن الرحلة إلى النجف من تلك الجهة مدة طويلة أي منتصف القرن السادس حيث عصر ابن إدريس(3) وسديد الدين الحمصي (4) في الحلة إلى منتصف القرن التاسع حيث عصر ابن فهد الحلي (5) فيها، وهو آخر عصورها المشرقة.
على أن حوزة النجف الأشرف لم تنتقل ولم تطفأ جذوتها وإن كانت فترت فتورا ملحوظا، فقد ظهر فيها طوال هذه الفترة طائفة من العلماء المشاهير سواء كانوا ممن خرّجتهم المدينة نفسها أو ممن جاوروا فيها حتى جاز لنا أن نطلق عليهم (علماء الفترة في النجف)(6).
ثم لمّا هرمت الحلة وانقضى عهدها العلمي عاودت حوزة النجف الأشرف
ص: 30
نشاطها من جديد فدارت فيها رحى الفقه وأصوله وعلوم الشريعة دورتها الحيوية بالعلم والعمل واتصلت أو كادت حلقات عصورها العلمية من أول القرن العاشر أي منذ سنة ( 900 ه / 1495م) تقريبا إلى الآن فكان أولها عصر الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المحقق المشهور ومعاصره الشيخ إبراهيم القَطيفي.. ثمّ عصر الشيخ الأردبيلي الزاهد وصاحبه الملّا عبد اللّه اليزدي.. ثمّ عصر الشيخ عبدالنبيّ الجزائري.. ثمّ عصر الشيخ حسام الدين النجفي، فعصر الشيخ فخر الدين الطريحي.. ثمّ عصر أبي الحسن الشريف ومعاصريه، فعصر الفُتوني، فعصر الطباطبائي، فعصر الشيخ جعفر الكبير، فعصر ابن الشيخ فعصر صاحب الجواهر، فعصر الشيخ مرتضى الأنصاري، فعصر تلامذة الأنصاري وغيرهم.. فهذه حلقات هذه السلسلة من العصور الآخِذِ بعضُها بأطراف بعض. وقد تكونت في أثنائها أشهر الأُسَر المعروفة بالعلم والأدب، كآل الخمائسي وآل الطريحي وآل الجزائري وآل محيي الدين وآل البلاغي وآل الطباطبائي وآل الشيخ جعفر وآل النحوي وآل الأعسم وآل الجواهر وآل القزويني وآل قَفطان وآل الشيخ راضي، وسواهم من البيوتات المعروفة والمندرسة(1).
وقد ترجم بعض الباحثين(2) لعلماء جامعة النجف الأشرف خلال القرون الماضية فكان الذين عثر على أسمائهم من علمائها ومؤلفيها خلال النصف الثاني من القرن السادس الهجري (18) عالما تقريبا، ثُمْن هذا العدد مؤلفين في التفسير والحديث والشعر. وقد انخفض هذا العدد إلى (13) عالما في القرن السابع الهجري، ثم عاد ليرتفع في القرن الثامن إلى (19) عالما، حيث نشطت الحركة العلمية بعد الفتور السابق حيث كتب في هذا القرن حيدر بن علي بن حيدر الآملي الذي جاور أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) ثلاثين عاما كتابه الرائد في تفسير القرآن من وحي الفلسفة والعرفان وسماه (المحيط الأعظم) في سبع مجلدات، إضافة إلى ما تركه الآملي من كتب أخرى في الفلسفة والأخلاق
ص: 31
والعرفان، كما كتب في هذا القرن علي بن محمد بن علي الكاشي في علم الكلام والمنطق والفقه والجغرافيا، وكتب الباحثان عبد اللّه بن محمد بن علي الأعرج الحسيني ومحمد بن علي الجصاني كتبا في علم أصول الفقه، وألف الأخير أيضا في الفلسفة والفقه والكلام، وصنف محمد بن علي الجرجاني الغروي كتبا كثيرة في معظم حقول المعرفة، وحبّر عبد الرحمن بن محمد العتائقي كتبه في الرياضيات والجغرافيا والطب فكانت كتبه (الإرشاد في معرفة الأبعاد) و(الرسالة الفريدة في الأدوية الفريدة) و(شرح حكمة الأشراف) و (التصريح في شرح التلويح) في الطب من الكتب المهمة التي ألفت في هذا العصر.
وما أن حل القرن التاسع الهجري حتى بلغ عدد العلماء والباحثين الذين تم إحصاؤهم فيه (30) عالما وكاتبا ومؤلفا منهم: الحسن بن محمد الاسترابادي مؤلف كتاب (معارج السؤل في تفسير خمسمائة آية من آيات الأحكام)، والشيخ جعفر الحبلرودي المؤلف في علوم المنطق والعقائد والمقداد السيوري المصنف في الفقه والعقائد والحديث، والسيد علي بن عبد الكريم الحسيني النجفي الكاتب في التفسير والعقائد والأخلاق والرجال.
وفي تطور ذي مغزى علمي واضح شيّد المقداد السيوري مدرسته الدينية لإيواء طلاب العلوم الدينية الوافدين على النجف الأشرف للدراسة.
أما في القرن العاشر الهجري فقد ارتفع عدد العلماء بشكل كبير لما للحركة العلمية التي أدارها الشيخ علي بن عبد العالي الكركي من أثر ملحوظ في ذلك حيث تجاوز عدد علماء القرن العاشر في حوزة النجف الأشرف إلى (71) عالما منهم: ابن بدر الدين الحسن الحسيني الغروي من أجلاء تلاميذ المحقق الكركي ومؤلف كتابي: (كدّ اليمين وعرق الجبين) و (ترجمة الرسالة الجعفرية)، ومن هؤلاء العلماء أيضا الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي مؤلف كتاب (الهادي إلى الرشاد في شرح الإرشاد) والعديد من
ص: 32
المؤلفات الأخرى، وكذلك الشيخ أحمد أبي جامع العاملي من تلاميذ المحقق الكركي ومؤلف كتاب (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، والشيخ أحمد بن محمد بن خاتون من تلاميذ المحقق الكركي أيضا، وكذلك العالم حسن الفتال النجفي.
وفي القرن الحادي عشر الهجري نشطت حلقات البحث والتأليف والتحقيق في الفقه والأصول، كما نشطت في ظلهما الحركة العلمية في علوم أخرى مصاحبة حيث صنف العديد من علماء حوزة النجف الأشرف التي تجاوز تعدادهم في هذا القرن (159 ) عالما كتبا في علوم الحساب والطب واللغة والرجال والتاريخ، من ذلك مثلا ما كتبه إبراهيم بن نصير الدين الرضوي في (خلاصة الحساب)، وما ألفه الشيخ حسين أبي جامع في الطب، وإبراهيم بن عبد اللّه في (مشيخة الاستبصار)، وماخطه يراع السيد أبي طالب في كتابه (لوامع النجوم) في اللغة، وما دبجه الشيخ حبيب بن إبراهيم النجفي في كتابه (أنيس الملوك) في التاريخ.
وهكذا بدأ أعداد علماء حوزة النجف الأشرف تزيد باطّراد بمرور السنين والأعوام حتى بلغ عدد من أحصي منهم في القرن الثاني عشر الهجري (211) عالما، ثم ازداد عدد علمائها ثانية فبلغ من أحصي منهم في القرن الثالث عشر الهجري (281) عالما، أما في القرن الرابع عشر الهجري فقد ارتفع عدد علمائها ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ عددهم حدود (534) عالما وفقيها ومفسرا ومحدثا ورجاليا وحكيما و أصوليا وغيرهم من الباحثين والمؤلفين في شتى صنوف علوم الشريعة والعلوم المصاحبة الأخرى.(1)
إن إلقاء نظرة فاحصة على أدوار تقدم البحث المعرفي في حوزة النجف الأشرف منذ (سنة 448 ه / 1055م) إلى اليوم توحي للناظر اليها أنها مرت بأدوار خمسة هي:
ص: 33
يبدأ هذا الدور منذ أن حلّ في مدينة النجف الأشرف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (سنة 448 ه / 1056م) الملقب ب(شيخ الطائفة) المتوفى في مدينة النجف الأشرف (سنة 460 ه / 1068م) وينتهي ببزوغ نجم الشيخ علي بن عبد العالي الكركي الملقب ب(المحقق الثاني) المتوفى في مدينة النجف الأشرف (سنة 940 ه/ 1533م)، وقد سبق أن تحدثت آنفا عن هذا الدور بإيجاز.
تعاقبت على جامعة النجف الأشرف العلمية أسوة بالجامعات والمعاهد العلمية العريقة الأخرى فترات تقدم علمي وازدهار، أعقبتها لظروف خاصة فترات تباطؤ معرفي وفتور، تلتها أدوار رقي وانبعاث بفعل فتح باب الاجتهاد على مصراعيه في مدرسة النجف الأشرف العلمية.
ولعل ما قدمته زعامة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المعروف بالمحقق الثاني المتوفى في النجف الأشرف يوم الغدير من عام (940ه/ 1533م) كما أسلفت، صاحب کتاب (جامع المقاصد في شرح القواعد) للحوزة العلمية النجفية بخاصة، وللحوزة العلمية بعامة، من نهوض فكري يعد بحق ملمحا من ملامح تطور معرفي ملحوظ، ومؤشر جلي لتباشير نهوض فكري واعد.
ويعد كتابه (جامع المقاصد) وهو شرح استدلالي كبير لكتاب (القواعد) للعلامة الحلي(1) المتوفى عام (726ه / 1326م) من أهم ما ألف في تلك الفترة، وقد وصل عدد أجزائه المطبوعة حديثا حتى نهاية كتاب الوصايا ثلاثة عشر مجلدا، ما يكشف عن سعة الكتاب وكثرة،مباحثه وقد نقل المحدث النوري في ختام مستدركه المهم
ص: 34
عن الشيخ محمد حسن النجفي المرجع الأعلى في عصره وصاحب الكتاب الموسوعي الشهير في الفقه (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) قوله: إن من كان عنده كتب: جامع المقاصد، والوسائل، والجواهر، لا يحتاج بعدها إلى كتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الشرعية، ولعل أهم ما يتقدم به كتاب جامع المقاصد عما سبقه مما ألف في علم الفقه قوة استدلاله العلمي وعمق مباحثه، ولا زال لكتاب جامع المقاصد دوره العلمي المرموق عند الفقهاء والباحثين منذ تأليفه وحتى يوم الناس هذا وإن كان جامع المقاصد لا يشكل دورة فقهية كاملة فقد وصل إلى مبحث تفويض البعض من كتاب النكاح وانتهى ليكمله الفاضل الهندي بعد وفاته.
ما قدمته من بعده زعامة الشيخ أحمد بن محمد المعروف بالمقدس الأردبيلي(1) المتوفى (عام 993 ه / 1585م) صاحب كتاب (مجمع الفائدة والبرهان) للحوزة العلمية النجفية من أثر فاعل أهَّل جامعة النجف الأشرف العلمية لأن تحظى بأهمية بحثية ملحوظة في عصره، ودور رائد في بناء حاضرة علمية رصينة مستقبلا، حيث يعد كتابا (جامع المقاصد) للشيخ الكركي، و (مجمع الفائدة والبرهان) للمقدس الأردبيلي المتقدم ذكر هما من أمهات المراجع في الفقه الاستدلالي في الوسط العلمي الإمامي.
وكتاب (مجمع الفائدة والبرهان) كتاب استدلالي كبير استعرض فيه المقدس الأردبيلي آراء الفقهاء السابقين عليه في ثوب تحقيقي متين مشغول بإضافات بحثية جديدة أعطته نكهة علمية متميزة وأهلته ليحتل دورا رائدا في صدارة الحوزة العلمية النجفية.
وبما انتهى اليه الكتابان القيّمان المتقدم ذكرهما من تطور بعدما تكاملت في الوسط العلمي النجفي أدوات البحث الفنية ووسائله العلمية في التحليل والتعليل والاستقراء والاستنتاج والموازنة والمقارنة والنقد والمناقشة وما إلى هذه من أمور استقر ووضح
ص: 35
الخط العام للتأليف في الفقه الاستدلالي في المادة والمنهج وأسلوب العرض(1).
ثم ما قدمه زعماء الحوزة العلمية اللاحقون لهما من العلماء المجتهدين من أمثال السيد محمد بن السيد علي الموسوي الجبعي المتوفى (عام 1009ه/ 1600م) صاحب كتاب (مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام) في الفقه، والشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني المتوفى (عام 1011 ه/ 1602م) صاحب كتاب (معالم الدين وملاذ المجتهدين)، من غنى فكري وأصالة قد خلّف أثره الكبير في ماضي هذه الحوزة العريقة بل وحاضرها.
فكتاب (مدارك الأحكام) مشحون بالأقوال والتحقيقات المهمة التي فتحت المجال الواسع لكثير ممن تأخر عنه من الفقهاء في محاولة للوصول إلى أعلى مراتب النضج، وعكف عليه جمع من طلاب الفقه لدراسته فكان إلى فترة قريبة يعتبر أحد المراجع التي لابد أن يستوعبها الطالب في مراحل تحصيله العلمي(2).
وكتاب (معالم الدين وملاذ المجتهدين) هو الآخر كسابقه من حيث العمق والدقة، بيد أن ما يؤسف له أن مؤلفه لم يكتب منه سوى كتاب الطهارة فقط، ولقد كان مقصود مؤلفه (قدّس سِرُّه) أن يؤلف في الفقه كتابا يعكس آرائه العلمية وما يمتاز به من دقة النظر فشرع في تأليف هذا الكتاب وابتدأه بالحديث عن فضل العلم والحث على طلبه ثم بمقدمة تضمنت جملة من آرائه في أصول الفقه وهي التي أصبحت بعد ذلك الكتاب الدراسي المشهور في هذا العلم حتى عصورنا المتأخرة وتصدى جملة من الأعلام لشرحه والتعليق عليه فأصبح السبب الرئيس لشهرة مؤلفه وصار علما له يغني عن ذكر اسمه أو نسبه الشريف مع أنه كتبه مقدمة للفقه إلّا أنه لم يبرز من قلمه غير كتاب الطهارة فكأنه مصداق للقول المشهور : ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إذ أنه إنما كتب في الأصول مقدمة للدخول في الفقه لكنه لم يكمل ما أراده من الفقه ولم يلق ما كتبه منه وهو كتاب
ص: 36
الطهارة الاهتمام اللائق به في حين أن مقدمته الأصولية التي كتبها مدخلا للفقه حظيت بالنصيب الأوفر من الاهتمام(1).
لقد حاول مؤلف كتاب المعالم أن يستقصي الآراء في كل مسألة من المسائل التي بحثها مع أدلتها ثم ناقشها منتهيا إلى رأي فيما عرض وناقش موليا اهتمامه الواضح لرأي العلمين الجليلين السيد المرتضى المتوفى (عام 436 ه/ 1044م)(2) وتلميذه الشيخ الطوسي المتوفى عام (460 ه/ 1067م) (3) كما أسلفت مقتصرا في كتابه على أساسيات المطالب الأصولية، حاذفا منها ما لا ضرورة له حسب تشخيصه مع جمال في الصياغة ودقة في التحليل وتعديل في المنهجة، ولعل ذلك هو ما حدا بالوحيد البهبهاني إلى تدريسه مرارا، وأعادت كتابة تعليقاته عليه في كل دورة تدريسية جديدة.
ولا يفوتني أن أذكر ما أضافه الشيخ عبد اللّه بن محمد البشروي الخراساني المعروف بالفاضل التوني(4) المتوفى عام (1071 ه/ 1660م) من تجديد في علم الأصول تمثل في إعادة تبويبه للمنهج المعمول به لدى من سبقه من الأصوليين من خلال مبادرته لفصل المباحث العقلية عن مباحث الألفاظ، وتقسيمه الأدلة إلى شرعية وعقلية، ثم تقسيمه للأدلة العقلية إلى ما يستقل العقل بحكمه وما لا يستقل وذلك في كتابه (الوافية) في أصول الفقه.
ومن يقارن بين كتابي (المعالم) و (الوافية) يدرك النقلة العلمية التي أحدثها كتاب (الوافية) في المنهجية وفي نمط التفكير وصياغة المطالب، والدخول إلى البحث من مسلك لم يعهد من قبل(5) من خلال معايير علمية لم يسبقه اليها سابق.
ولم تقتصر تلك الفترة الغنية من عمر مدرسة النجف الأشرف العلمية تأسيسا أو تطويرا أو استفادة على ما ذكرت من كتب وأبحاث في علمي الفقه وأصوله فقط، بل
ص: 37
تعدت ذلك إلى التأليف التطوير في العلوم الأخرى الرئيسة والمساعدة، كتلك التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، أو تلك التي تعين عليها، أو تزكي النفوس وتهذبها من أدران الدنيا وزخارفها، أو تلك التي تعين الجسد على الوقاية والعلاج كي يستمر في أداء دوره في هذه الحياة الدنيا.
فقد حبّر الفيلسوف المفسّر جلال الدين الدواني(1) المتوفى (سنة 907ه/ 1501م) كتابه (الزوراء) جوار المرقد العلوي المطهر في النجف الأشرف حيث جمع فيه بين الحكمة البحتة والذوقية في طريق إثبات الواجب(2) كما كتب (حاشيته على الزوراء) جوار مرقد أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعد أن رأى سيده أمير المؤمنين في منامه(3).
وصنّف الملا عبد اللّه بن شهاب الدين اليزدي(4) المتوفى (عام 981ه/ 1573م) كتبه المتعددة في علم المنطق، تلك التي اشتهر منها كتابه (الحاشية) في علم المنطق الذي صنّفه في النجف الأشرف (سنة 967ه/ 1559م)، وكتاب (الحاشية) وإن كان معقد العبارة مستصعبها، إلّا أنه رغم ذلك استطاع أن يفرض نفسه ككتاب دراسي معتمد لمادة علم المنطق في الحوزة العلمية النجفية، بل في الحوزات العلمية الأخرى حتى وقت قريب، ولقد بلغ من تضلع مؤلفه الشيخ في علم المنطق أن قال: إني لو شئت أن اقيم على كل مسألة شرعية برهانا من أدلة المعقول بحيث لم يكن لأحد ردّه لفعلت.
كما ألف الشيخ أحمد بن محمد المعروف بالمقدس الأردبيلي(5) - المتقدم ذكره- المتوفى عام (993ه/ 1585م) كتابه (زبدة البيان في شرح آيات القرآن)، وصنَّف هو نفسه كذلك كتاب (شرح) إلهيات التجريد) في علم الكلام.
وكتب الشيخ عبد النبي سعد الدين الأسدي الغروي الحائري(6) المتوفى (سنة 1021ه / 1612م) كتابه (حاوي الأقوال في معرفة الرجال) مرتبا فيه الرجال على
ص: 38
أربعة أقسام على حسب القسمة الأصلية للحديث الصحيح، والموثق، والحسن، والضعيف، وترك المجاهيل. وقيل إنه أول من فعل ذلك(1).
وسطّر الأمير السيد فيض اللّه الحسيني النجفي(2) المتوفى (سنة 1052ه / 1612م) كما قيل كتابيه (تعليقات على إلهيات شرح التجريد) و (تعليقات على آيات الأحكام).
وصنّف الأمير السيد علي الطباطبائي الحكيم (3) المتوفى بعد سنة (1052 ه / 1612م) كتابه في الطب والصيدلة المسمى (المجربات الطبية)، وتوجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة الإمام الحكيم العامة في النجف الأشرف.
وبرع الشيخ فخر الدين الطريحي(4) المتوفى (عام 1085ه / 1674م) في تصنيف كتابيه (مجمع البحرين) في شرح مفردات القرآن الكريم والحديث الشريف وبخاصة الغريب منهما، وقد اهتم هذا الأثر العلمي بإبراز الدلالات اللغوية لمفردات القرآن الكريم والسنة المطهرة وما يمكن توظيفه منهما في مجال استنباط الأحكام الشرعية. و(جامع المقال في تميز المشترك من الرجال) الذي قال عنه الشيخ جعفر محبوبه(5) بأنه کتاب نافع جدا لم يعمل مثله.
ودوّن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ نور الدين بن أبي جامع(6) المتوفى (عام 1050ه / 1640م) كتابا في الرجال بمنهجية جديدة وهو كتاب صغير الحجم كثير الفائدة اقتصر فيه على خصوص رجال الكتب الأربعة، وهو أول من اشار إلى طبقات الرواة في أصحابنا قال (رَحمهُ اللّه) وحيث أن معرفة الراوي ضرورية جعلت الطبقات ستة:
1 - طبقة الشيخ المفيد.
2- الصدوق.
3- الكليني.
ص: 39
4- سعد بن عبد اللّه.
5- أحمد بن محمد بن عيسى.
6 - ابن أبي عمير.
ليتضح الحال في وهلة، وأشير في الأغلب إلى طبقة الراوي اما بروايته عن الإمام أو بنسبته إلى أحد المشاهير من أعلى وأسفل أو بكونه من إحدى الطبقات المذكورة(1).
ودبج يراع الباحث محمد حسين بن محمد علي الكتابدار(2) النجفي المتوفى (سنة 1095 ه/ 1683م) كتابه ( تعليقة على كتاب عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب) لابن عنبة في علم الأنساب.
وكتب الشيخ أبو الحسن بن محمد طاهر الفتوني(3) المتوفى (عام 1138ه/ 1725م) كتابه (ضياء العالمين) في الإمامة، وهو من الكتب النفيسة في بابه، يقول صاحب (ماضي النجف وحاضرها )(4) عنه أنه يقع في ثلاث مجلدات ضخام لم يكتب أوسع منه في موضوعه وتوجد نسخة منه بخطه في (مكتبة آل الجواهري) في النجف الأشرف، كما كتب في التفسير كتابه (مرآة الأنوار) أيضا.
وألّف الشيخ أحمد بن إسماعيل بن عبد النبي الجزائري(5) المتوفى (عام 1151ه / 1738م) كتابيه (قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر) في تفسير وفقه القرآن الكريم، و(آداب المناظرة).
وسطّر الشيخ محمد علي ابن الشيخ بشارة(6) المتوفى (عام 1160ه / 1747م) کتابه (نشوة السلافة) وهي ذيل على كتاب (سلافة العصر) وقد أثنى على (نشوة السلافة) كثير من معاصريه ولاحقيهم من أهل الفن واستفاد منها (الشيخ جعفر محبوبه) في تأليف كتابه (ماضي النجف وحاضرها) فائدة ملحوظة.
ص: 40
وصنّف الشيخ محمد مهدي بن أبي ذر النراقي النجفي(1) المتوفى (سنة 1209ه/ 1794م) كتابة القيم (جامع السعادات) في علم الأخلاف وتربية النفس في محاولة منه لبناء منظومة للقيم الأخلاقية مبنية على أساس متوازن يجمع بين الدين والدنيا في آن.
كما أولى (الشيخ النراقي) علم الأديان اهتمامه الخاص فحرص على تعلم اللغتين العبرية واللاتينية على يد جماعة من اليهود والنصارى لتسهيل أمر رجوعه إلى كتبهم والاطلاع على مبادئهم وأفكارهم من مصادرها الأصلية.
وقد كتب إضافة لذلك كتابيه (المستقصى) و (المحصل) في علم الهيئة، وكتابه (توضيح الإشكال) في شرح تحرير إقليدس الصوري، وكتابه (رسالة في الحساب) وكتابه (محرق القلوب) في السيرة.
كما أن ما خلفته تلك الحقبة الزمنية الغنية جدا بفنون القول من شعر ونثر، وما ضمته بين دفتيها من دواوين وكتب كان لها دور كبير في صون اللغة العربية من حملات التتريك والحفاظ على عمود الشعر العربي بخصائصه الفنية وجماله الأخاذ ولغته المترفة وصوره المبدعة من كل محاولات العبث بجماله الآسر. وقد طبعت أغلب هذه الكتب وتداولتها أيدي الباحثين باهتمام كبير.
إن هذه التصانيف القيمة في علوم مختلفة متعاضدة إضافة إلى ما صُنّف في تلك الحقبة الزمنية من كتب ورسائل في مجالات أخرى عديدة كالحديث والتاريخ والتراجم والسير والفلسفة والحكمة والفلك والرياضيات وغيرها مما لا يسع المجال للتنويه بها في هذا الموجز قد ساهمت جميعها بشكل فاعل في تقدم البحث المعرفي في حاضرة النجف الأشرف العلمية تلك الآونة.
ص: 41
يبدأ هذا الدور منذ أن حل في رحاب النجف الأشرف تلامذة الشيخ محمد باقر البهبهاني المعروف بالوحيد البهبهاني(1) المتوفى (عام 1208ه/ 1793م)، وفي مقدمتهم السيد محمد مهدي بحر العلوم (المتوفى سنة 1212ه/ م)، وينتهي ببزوغ نجم الشيخ مرتضى الأنصاري (المتوفى سنة 1281ه/ 1864م).
لقد استمرت مدرسة النجف الأشرف الفكرية وحوزتها العلمية تحث الخطى في دراسة وبحث علوم الشريعة وآدابها بيد اني سأتناول في حديثي اللاحق ما يتعلق بدور النضج المعرفي في النجف الجامعة من خلال علمي الفقه و أصول الفقه دون غيرهما محيلا الحديث عن بقية العلوم الأخرى إلى مجال آخر، حيث توسّع مسار البحث المعرفي في علمي الفقه و أصوله في النجف الأشرف نتيجة فتح باب الاجتهاد على مصراعيه فيها حتى وصلت جامعة النجف الأشرف لما يمكن أن نسميه بدور نضج البحث المعرفي فيها على يد تلامذة الشيخ محمد باقر البهبهاني(2) المعروف بالوحيد البهبهاني المتوفى (عام 1208 ه/ 1793م) المتقدم ذكره الذي أعطى علمي الفقه والأصول دفعة قوية من خلال تصديه القوي للمد الأخباري في وقته، وتهذيبه لعلم الأصول منهما خاصة مما علق به من آراء ومبان غريبة قد يكون بعضها من الشواذ، وربما كان أطلق عليه لقب (الوحيد) بسبب ذلك.
وقد يعزى بروز المد الإخباري تلك الآونة من بين أسباب أخرى إلى قلق علمي من ابتعاد تدريجي عن النص الشرعي في عملية الاجتهاد والغوص أكثر فأكثر في تغليب العنصر العقلي عليه. من دون استبعاد لوجود عامل سياسي بسبب توجس ملوك الدولة الصفوية من اتساع دائرة نفوذ العلماء في أجهزة الحكم والدولة إضافة لسيطرتهم على الشارع الشيعي بقوة، مما يشكل خطرا محتملا على سلطتهم المحتاجة إلى العلماء والمعتمدة
ص: 42
عليهم ولكن ضمن سقف محدد لا يسمح لهم بتخطيه.
اشتهر الشيخ الوحيد البهبهاني (قدّس سِرُّه) تدخل بدقة تحقيقه للمسائل والفتاوى والآراء والنظريات العلمية في علوم الرجال والحديث والفقه وأصول الفقه وتكثيره للأدلة وتبديهها وهو ما أودعه في كتبه ورسائله وتعليقاته التي بلغ مجموعها (109)، بينها (50) في علم الفقه وحده، و (28) في علم الأصول.
ولا ريب في أن الجذور المهمة للمدرسة الأصولية الحديثة في يومنا هذا تعود إلى جملة من النظريات التي جاء بها الوحيد وانعكست في كتب تلامذة مدرسته بشكل واضح إذ نلمس أصولها وركائزها في أحد أهم كتبه الأصولية الذي عرف ب- (الفوائد الحائرية).
إن أهم النظريات التي طرحت في مدرسة الوحيد البهبهاني
1 - التفريق بين الأمارات والأصول، فإن الجذور الأولى لهذا التفريق كانت من الوحيد على ما ذكره الشيخ الأنصاري في بداية المقصد الثالث من رسائله حينما تعرّض للأدلة الاجتهادية (الأمارات) والأدلة الفقاهتية (الأصول العملية).
2 - التنظير والتقسيم للشك الذي اعتمده الشيخ الأنصاري في منهجيته الحديثة لمباحث علم الأصول، فإنه يعود إلى تقسيم الوحيد للشك إلى قسمين: الشك في التكليف، والشك في المكلف به وتعيين الوظيفة العملية المترتبة على كل منهما.
-3- الصياغة الفقهية المتينة لقاعدة البراءة العقلية التي استقرت في الفكر الأصولي المعاصر، فإنها تعود إلى الوحيد البهبهاني (قدّس سِرُّه)(1).
ص: 43
إضافة إلى الجدة الملفتة في نظرياته الأخرى من أمثال: تنجيز العلم الإجمالي، ودوران الأمر بين الأطراف المتباينة أو الأقل،والأكثر الوظيفة العقلية لدى الشك في التكليف وغيرها وما تضمنتها (فوائده) العديدة كالفائدة الثانية التي بينت تحديد مواضع الرجوع إلى العقل والعرف ومواضع الرجوع إلى النص الشرعي وتحديد دائرة الاجتهاد فيما لا نص صريح فيه والفائدة الرابعة في مدى جواز أخذ موضوع الحكم من العرف إذا كان من المعاملات مادام لم يكن للشرع بيان خاص ومصطلح واضح، وكالفائدة الحادية والعشرين الخاصة في المرجحات المنصوص عليها وتعارضها فيما بينها والثانية والعشرين الخاصة في المرجحات غير المنصوصة والفائدة الثالثة والعشرين الخاصة في كيفية الجمع المقبول بين الخبرين المتعارضين. وكالفائدة السادسة والثلاثين الخاصة في شرائط الاجتهاد والعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد واستنباط الأحكام إضافة إلى الخاتمة المهمة التي تناولت خطورة ووعورة السير في طريق الاجتهاد، والأهمية القصوى لتهذيب النفوس من أدران الدنيا وزخارفها وتنظيف الباطن من شوائبه المادية ووساوسه لتحصيل القوة القدسية، ومجاهدة النفس بمكارم الأخلاق، وهو ما نحتاجه كثيرا في زمننا(1).
وتأتي في مقدمة كتب الوحيد البهبهاني ورسائله وحواشيه من حيث الأهمية عدا الفوائد الحائرية حاشيته على (المدارك) و(المفاتيح).
ولعل من أهم إنجازاته العلمية الأخرى اللافتة للنظر والمؤثرة في طور نضج البحث العلمي في حوزة النجف الأشرف ما تم على يديه من تنشئة جيل باحث متعمق من الفقهاء المجتهدين يأتي في مقدمتهم المرجع العارف السيد محمد مهدي بحر العلوم(2) المتوفى عام (1212ه/ 1797م) وغيره كما تقدم
ص: 44
لقد خلّف لنا السيد بحر العلوم كتابه (المصابيح) في الفقه، وكتابه (الفوائد الرجالية) في علم الرجال، وشرحاً لكتاب (الوافية) في علم أصول الفقه، ومنظومة أصولية أسماها (الدرة البهية في نظم رؤوس المسائل الأصولية).
والسيد بحر العلوم إلى جانب فقهه و أصوله وعرفانه وزعامته صاحب ذوق أدبي وشعري رفيع، بل هو شاعر يحتكم اليه الشعراء لتمييز نتاجهم الشعري، ولقد بلغ من اهتمامه بالشعر والأدب إدراكا منه لمدى علاقة اللغة وآدابها بالفقه واستنباط أحكامه أنه كان يقبِّل يدي تلميذه في الدراسات الفقهية الشاعر السيد صادق الفحام وفاء لحق تتلمذه عليه في الشعر والأدب وفنون الكلام.
ومثله في الاهتمام بالأدب وفنونه والشعر ونسجه كان الشيخ جعفر الكبير(1) آل كاشف الغطاء(2) المتوفى (عام 1228 ه/ / 1813م) صاحب كتاب (كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء)، وهو من التصانيف المهمة التي أسهمت في تطوير علوم عديدة في مقدمتها علوم : أصول العقائد، و أصول الفقه، والفقه، تطويرا مشهودا له بما اشتمل عليه كتابه القيم من مقدمتين مهمتين: أولاهما في أصول العقائد، والثانية في أصول الفقه، ثم بما استعرضه الشيخ في كتابه من بحوث عميقة في أبواب الفقه ابتداء من باب العبادات وحتى آخر كتاب الجهاد، وكذلك ما ألحقه به بعد ذلك کتاب الوقف وتوابعه، وقد عرف عن الشيخ كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه) دقة تفريعه للمسائل الفقهية، وجمال شمّه الفقاهتي المميز، وحسن فهمه وتطبيقه لألفاظ الكتاب والسنة على طريقة الفهم العربي السلیم، وبراعة طرحه لقواعد حديثة لم يسبقه اليها أحد، حتى قال عنه الشيخ الأنصاري قولته المهمة: في اعتقادي أن من يتقن قواعد الأصول التي أوردها الشيخ في أول كشف الغطاء يكون قد بلغ الاجتهاد، كما ان الأهمية الخاصة التي يتعامل بها الشيخ الأنصاري في مكاسبه مع المباني الاجتهادية للشيخ جعفر لم يتعامل بها مع
ص: 45
أي شخص آخر حتى أساتذته مثل صاحب الجواهر وغيره. ومن ثم نرى في المكاسب عبارة (بعض الأساطين) إشارة إلى الشيخ جعفر، وعبارة (بعض المعاصرين) إشارة إلى صاحب الجواهر، وكان الشيخ الأنصاري يتعامل مع آراء كاشف الغطاء بغاية الاحتياط، ويحاول أن يخلص إلى تأييدها(1) في رأيه المختار، وكان له ولأبنائه المراجع الفقهاء: الشيخ موسى والشيخ علي والشيخ حسن دور مشهود في دفع عجلتي الفقه والأصول في حوزة النجف الأشرف إلى الأمام.
وقد عرف عن الشيخ جعفر الكبير آل كاشف الغطاء وأولاده المراجع رهافة حسه الأدبي الرفيع وبراعة وجزالة نظمهم للشعر الرقيق كما عرف عن الشيخ جعفر حفظه على خاطره جميع الكتب السماوية من إنجيل وزبور وتوراة وجميع ذلك بآياتها وفصولها وينبئك على ذلك ما ذكره في كتابه كشف الغطاء من الاستدلال على نبوة نبينا (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) فقد سرد منها هناك ثلاث أوراق أو أكثر من عباراتها باللسان التي نزلت به ثم ترجمها إلى العربية وبيّن تناقض بعضها مع بعض وأنها محرفة عمّا أنزلت به، ويذكرهم الأصل(2) الذي كانت عليه.
وهكذا استمرت مناهج الحوزات العلمية في طور النضج والتكامل شيئا فشيئا منبعثة أو منعكسة على حوزة النجف الأشرف، فقد أبدعت موهبة الأصولي الشاعر الملا مهدي النراقي الكاشاني(3) المتوفى (عام 1209 ه / 1794م) كتابه القيم (تجريد الأصول) وكان لما صنفه يراع السيد جواد العاملي(4) المتوفى (عام 1226ه / 1794م) في كتابه (مفتاح الكرامة) من عمق وإحاطة بآراء وأقوال المجتهدين أثر مهم في النضج المعرفي، وما جادت به قريحة الشيخ أسد اللّه الدزفولي المعروف بالكاظمي(5) المتوفى (عام 1234 ه / 1818م) من شمول واستيعاب لمسائل وفروع مبحث الاجماع في كتابه الأصولي المهم (كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع)، ثم ما حققه السيد علي السيد
ص: 46
محمد الطباطبائي(1) المتوفى (عام 1231ه / 1816م) في دفتي كتابه (رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل) من غنى معرفي أسهم هو وما تقدم من كتب وأبحاث ودروس وتصنيفات في دفع الحركة العلمية في حوزة النجف دفعة مؤثرة إلى الأمام.
فكتاب (الرياض) كما يطلق عليه الحوزويون اختصارا هو أكبر شرح منشور ومشهور لكتاب المختصر النافع للمحقق الحلي(2)، ومن محاسن الرياض كونه دورة فقهية استدلالية كاملة ابتداء من كتاب الطهارة وانتهاء بكتاب الديات والظاهر من حاله متابعته لشرح اللمعة الدمشقية، ومن ثم قد ينفع في حل بعض غوامضها، بل قد ينقل فقرة منها أحيانا مضيفا اليها ما يراه ضروريا ولو لتوضيح المراد من دون أن يشير إلى المصدر.
قال بعض أعلام تلامذته عنه(3): هو في غاية الجودة جدا، لم يسبق بمثله، ذكر فيه جميع ما وصل اليه من الأدلة والأقوال على نهج عسر على من سواه، بل استحال. والمنقول عن صاحب (الجواهر) (رَحمهُ اللّه) أنه عندما ألف جواهره لم يقصد فيه قصد المصنفين من التفنن والتأنق في العبارة، وإلا لانتهج نهج صاحب الرياض.
هذا وهناك العديد من المجتهدين ممن أسهم في تطور البحث العلمي في الحوزات العلمية من غير هؤلاء الأعلام والفقهاء، من أمثال الميرزا أبو القاسم الكيلاني الرشتي المعروف بالميرزا القمي(4) المتوفى ( عام 1231ه / 1816م) صاحب كتاب (القوانين) في أصول الفقه المعروف بكونه الجامع الدقيق لمطالب علم الأصول عند من سبقه من العلماء خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، ولما أضافه لمباحث علم الأصول حتى عصره من عمق وتوسعة وتفصيل ولا سيما في المباحث العقلية، وبخاصة ما يتعلق منها بما يطلق عليه الأصوليون ب(دليل الانسداد)، ذاهبا إلى حجية مطلق
ص: 47
الظن لانسداد باب العلم الذي عرضه كتاب المعالم السابق ذكره وقد أبطله المحققون الأصوليون فيما بعد. وقد أصبح القوانين كتابا دراسيا من مناهج كتب علم الأصول في الحوزة العلمية حتى وقت ليس بالبعيد.
ثم بعد ذلك ما أتقن تحقيقه السيد محسن الأعرجي(1) المتوفى عام (1240 ه / 1825م) من بحوث في علمي الأصول والفقه وبخاصة تصنيفه لكتابيه في شرح كتاب الوافية في الأصول لعبد اللّه بن محمد البشروي الخراساني المعروف بالتوني المتقدم ذكره وهما: (المحصول في شرح وافية الأصول) وهو مختصر، و(الوافي) وهو مفصل.
ومن العلماء الذين أسهموا في دفع عجلة علم الأصول إلى الأمام الشيخ محمد تقي بن عبد الرحيم الحائري(2) المتوفى (عام 1248 ه/ 1832م) مؤلف كتاب (هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين) أفضل حاشية كتبت على كتاب المعالم وكانت لحاشيته التي اشتهر بها دور مثمر في ترسيخ بحوث علم الأصول وتوسيع وتعميق مبانيه ومطالبه، ويكفي في أهميتها قول الشيخ الأنصاري حين سئل : لماذا لا تؤلف كتابا في مباحث الألفاظ ؟ أجاب: تكفي مباحث الألفاظ في هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي(3).
والشيخ تقي ابن الشيخ محمد ملّا كتاب(4) النجفي المتوفى قبل (عام 1251ه / 1835م) مؤلف الكتاب الواسع في الأصول (الدلائل الباهرة في فقه العترة الطاهرة) الذي امتاز بمنهجية لعلم الأصول ظاهرة، حيث رتبه على مقدمة وخمسة أصناف وخاتمة وحصر المقدمة في مطلبين، الأول في بيان ما يدل على وجوب التفقه في الدين والثاني في بيان مباديه، والصنف الأول في مطالب أصول الفقه ورتبه على مقدمة
ص: 48
وثمانية أبواب وخاتمة، وجعل الباب الأول من الصنف الأول من الكتاب في المبادئ اللغوية، وهنا يشبع البحث في ذكر عدة أدلة تتضمن مباحث الألفاظ من حيث الكلام والكلمة والحقيقة والمجاز وغيرها مما يتعلق بالوضع والموضوع له وما يناسبه، والباب الثاني في الكتاب والسنة وهو المجلد الثاني من الكتاب وهنا يستوحي البحث عمّا يخص الكتاب من نزوله وحفظه وقرائه وطبقاتهم وعدم وقوع التحريف فيه، وفي السنة يستغرق البحث عن معنى الخبر ولفظه وعدالة الراوي وكل ما تعلق بالسنة قرظ هذا الكتاب الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء وولده الشيخ موسى، رأيت خط الشيخ الكبير وخاتمه وهذا نص عبارته: قد نظرته نظر اعتبار ونقدته نقد الدرهم والدينار فوجدته قد جمع فيه من الشوارد والنوادر ما حقّ أن يقال فيه : كم ترك الأول للآخر واحتوى على كثير من غريب الأشياء وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء(1).
وكذا الشيخ خضر بن شلال العفكاوي (المتوفى عام 1255 ه/ 1840م)(2) صاحب كتابي (التحفة الغروية في شرح اللمعة الدمشقية، ومصباح الرشاد ونجم الهداية) وهو شرح على كتاب ( هداية المسترشدين) للعلامة الحلي.
ومثله الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الرازي(3) المتوفى (عام 1261 ه / 1845م) صاحب كتاب (الفصول) في أصول الفقه، وهو شقيق الشيخ محمد تقي الحائري المتقدم ذكره، وقد بقي كتابه (الفصول) حتى وقت قريب كتابا دراسيا يدرسه الطالب الحوزوي، وهو يرتقي سلم هذا العلم درجة درجة، بل لازالت مسائله الأصولية حتى يوم الناس هذا محور بحث ومناقشة ونقد وتقييم.
والفقيه النجفي الشيخ حسن آل كاشف الغطاء المتوفى (عام 1262ه / 1846م)(4) المتقدم ذكره مؤلف كتاب (أنوار الفقاهة في علم الفقه، والمعروف بدقة شمّه
ص: 49
الفقاهتي وبراعة استقامة آرائه على طريق الاستدلال وتسلطه على المباحث الشائكة، والمشهود له بملكة التفريع والتصوير في الفقه.
والفقية النجفي الشيخ جواد ابن الشيخ تقي ملّا كتاب(1) المتوفى (عام 1264ه/ 1848م) مؤلف كتاب (الأنوار الغروية) وهو كتاب كبير الحجم أجاد فيه كل الإجادة، جمع فيه بين الأدلة والأقوال والأخبار بأوجز عبارة إلا أنه غير تام الفقه، بل وصل فيه إلى كتاب النكاح، وتوجد نسخة منه في كتب الشيخ صاحب (الحصون)، وهو عشرة مجلدات(2) ما يكشف عن سعته رغم حرص مؤلفه على ضغط عبارته واختصار كتابته.
كذلك الباحث الموسوعي والفقيه الضليع الشيخ محمد حسن النجفي(3) المتوفى (عام 1266 ه / 1850م) رأس الأسرة العلمية الأدبية المبدعة، وصاحب كتاب (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) في (43) مجلدا، لذا فهو أضخم موسوعة فقهية كاملة صنفت في الفقه الجعفري حتى نهاية عصره والعقود اللاحقة له، أقول كاملة لأن تلميذه العالم الزاهد الشيخ محمد حسين الكاظمي المتوفى (سنة 1308ه/ 1891م) ألّف كتابه المسمى (هداية الأنام في شرح شرائع الإسلام) بما يزيد على (الجواهر) وصل فيه إلى كتاب القضاء والشهادات وكان لا يترك فيه قولا لقائل إلّا نقله ونقل دليله وتكلم فيه واستقصى كلمات الفقهاء كلها فيه(4) بيد أنه لم يتم.
ويتفرد كتاب (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) من بين كتب الفقه الأخرى باشتماله على خلاصة أفكار الفقهاء المتقدمين والمتأخرين مع غاية التحقيق والتدقيق والفهم الجيد للروايات الشريفة ولسائر مدارك الأحكام، المنبئ عن سليقة عرفية سليمة وذوق فقهي عال، وقد استكمل (رَحمهُ اللّه) شرح أبواب (شرائع الإسلام) من كتاب الطهارة
ص: 50
إلى آخر الحدود والديات، ويمتاز عن أكثر المؤلفات الموسوعية التي تستغرق وقتا طويلا لإنجازها بأن أواخره كأوائله وهي مثل أواسطه في الجودة والدقة والاستيعاب بنفس واحد مبني على الاستقصاء والتحقيق، من دون أن يعرف الكلل والملل اليه سبيلا، وقد سمعت من بعض أساتذتي (رَحمهُ اللّه) أن سيدنا الأعظم الإمام الحكيم (رَحمهُ اللّه) في بداية رجوع الناس اليه في التقليد، وقبل أن يؤلف شيئا من كتب الفتوى، كان إذا ابتلي بمسألة يراجع (الجواهر) ويفتي حسب ما يتوصل اليه نظره الشريف بمعونته. وما ذلك إلّا ثقة منه (رَحمهُ اللّه) باشتمال الجواهر على عمدة ما يحتاجه الفقيه في مقام الاستنباط(1) وقد تقدمت الإشارة إلى أن من أتم مراجعة كتب: (وسائل الشيعة) للحر العاملي و(جامع المقاصد) للكركي و (الجواهر) فقد خرج عن عهدة وجوب الفحص.
ولقد صدر معجم باسم (معجم فقه الجواهر) في ستة مجلدات من القطع الكبير، متضمنا عددا كبيرا من المصطلحات والعناوين الفقهية ابتداء من حرف الألف وحتى حرف الياء، كما صدر بعده فهرست تحليلي باسم (جواهر الكلام في ثوبه الجديد)، والهدف منه تفكيك وتحليل أبحاث الكتاب واستخراج آراء ومتبنيات المؤلف على حدة، ثم تليها الاستدلالات والمناقشات والأقوال مرتبة ومرقمة، مع الإشارة إلى النكات الدقيقة فيها حتى يكون ذلك ضوء كاشفا ينير الطريق أمام المحققين والباحثين في معرفة مسائل هذا الكتاب(2).
ونظرا لأهمية هذا الدور وتنوعه وكثرة ما تم فيه من تأليف وكتب وبحوث أسهمت في تطور علمي الفقه وأصوله، فقد آثرت أن أشطره إلى أكثر من دور ومدرسة بحثية فقهية أصولية في كتابي الثاني الموسوم (حوزة النجف الأشرف عصورها العلمية وعلماؤها المعاصرون) الذي آمل أن يصدر في بداية العام القادم إن شاء اللّه.
ص: 51
يبدأ هذا الدور ببزوغ نجم مجدد علم الأصول الشيخ مرتضى الأنصاري(1) المتوفى عام (1281ه/ 1864م) صاحب كتابي: (المكاسب المحرمة) في الفقه، و(فرائد الأصول) في أصول الفقه، اللذين حظيا ولا زالا بعناية واهتمام الفقهاء والشراح والدارسين وينتهي ببزوغ نجم المحققين الثلاثة (والنائيني، والعراقي، والأصفهاني) وسيأتي التعريف بهم والحديث عن دور هؤلاء المحققين لاحقا.
ففي كتاب المكاسب أو المتاجر كما يطلق عليه الحوزويون تتعاضد مباحث ثلاثة :أولها المكاسب المحرمة وقد بحث فيه الكثير من الأمور التي يحرم التكسب بها، وثانيهما: كتاب البيع، وثالثهما : كتاب الخيارات، ثم أن الشيخ الأنصاري خطط لكتابه منهجا يقوم على أساس تقسيم موضوعه محل البحث إلى أقسامه المحتملة، ثم يشرع في بحث أقسامه المحددة واحدا بعد الآخر بتسلسل منهجي ملحوظ. ذلك أنك لا تكاد تجده يخوض غمار بحث موضوع ما من دون التقديم له بمقدمة تلقي الضوء على ما سيبحثه فيه دون أن يعود ثانية إلى نقطة تجاوزها سابقا.
نعم قد يكرّ الشيخ الأنصاري راجعا في بحثه إلى نقطة تجاوزها قبل ذلك مع مراعاة المبحث الواحد الذي هو فيه، وهو ما شكل صعوبة على دارس الكتاب أو مباحثه.
إن الفقه وإن كان قد قطع شوطا كبيرا في القرن الثالث عشر الهجري بيد شيخ الفقهاء صاحب الجواهر(قدّس سِرُّه) حيث إن كتابه احتوى من التحقيقات القيمة ما لا يستغني عنه فقيه حتى في اليوم الحاضر، إلّا أن ما أتى به الشيخ الأنصاري (قدّس سِرُّه) في خصوص الفقه المعاملي لم يأت به فقيه قبله، ولسنا نريد أن نقول: إن كل ما أتى به جديد فإن ذلك غير صحیح، كيف وقد استفاد ممن تقدمه من الفقهاء، وهذه سنة العلم يأخذ المتأخر من
ص: 52
المتقدم ويبني عليه إلّا اننا نقول: إن مجموع ما دونه في خصوص الفقه المعاملي من حيث المجموع وبهذه الكيفية والسعة والعمق، لم يأت به من سبقه(1).
أما في كتاب الشيخ الأنصاري الثاني (فرائد الأصول) أو ما يصطلح عليه الحوزويون بالرسائل فقد جاء بمنهجة جديدة أصبحت هي منهج الأصول في المباحث العقلية من بعده، ولم يتفق لأحد من قبله هذا الكشف والفتح الذي فتحه اللّه على يديه. وهذا المنهج آية في الاستحكام والقوة والمتانة العلمية والتنظيم المنهجي، وأمارة هذا الاستحكام والقوة والمتانة في المنهج والتصوير والمحتوى أن الفقهاء الذين جاءوا بعد الشيخ وهم كثيرون لم يغيّروا الحدّ اليوم الخطوط الأساسية لهذا المنهج(2).
كما أنهم رغم علو قدرهم لم يتجاوزوا منهجه العلمي بل يعتبرون أنفسهم وهم الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة المتميزة طلاب مدرسته العلمية التجديدية.
ولا زال كتابا (المكاسب) و(الرسائل) حتى يوم الناس هذا من مناهج الدراسة الأساسية المعتمدة في الحوزات العلمية التي لا يمكن علميا لطالب ينوي الاستمرار في دراسته العليا وحضور بحث الخارج إلّا بدراستها دراسة متأنية فاحصة سواء أكان من طلبة حوزة النجف الأشرف أم من طلبة غيرها من الحوزات العلمية الأخرى المنتشرة اليوم في شرق الأرض وغربها.
ثم جاء من بعده الثائر والمنظر في الفقه الدستوري والأصولي المحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني(3) المتوفى (عام 1329 ه/ 1911م) صاحب كتاب (كفاية الأصول)، الذي هو من كتب أصول الفقه الدراسية المعتمدة للآن في الحوزات العلمية كافة ومنها حوزة النجف الأشرف.
ففي كتاب (كفاية الأصول التي هي خلاصة مركزة لبحوثه في علم الأصول،عمد
ص: 53
المؤلف الضليع إلى ضغط العبارة واختصارها وإيجازها حد الغموض أحيانا، موشيا عباراته بالمحسنات البديعية ما أمكنه، وقد عرفت دروس الشيخ الخراساني وكتاباته في كتابه الكفاية بدقة مطالبها وعمقها وتركيز مباحثها واختصارها وقد وصف السيد محسن الأمين(1) (قدّس سِرُّه) تمثل هذه الخصائص في مباحث الشيخ الخراساني بقوله : وتميز عن جميع المتأخرين بحب الإيجاز والاختصار وتهذيب الأصول والاقتصار على لباب المسائل وحذف الزوائد مع تجديد في النظر وإمعان في التحقيق مزاوجاً في مباحثه بين المسائل الفلسفية والمسائل الأصولية أكثر ممن سبقه من مؤلفي الكتب الأصولية المعروفة المتداولة التي مرّ ذكرها من أمثال الرسائل والفصول والقوانين، ولذلك وغيره كثرت على متن الكفاية الحواشي والشروح منذ عصر مؤلفه عصرنا الحالي، وقد أحصى الأستاذ المرحوم عبد الرحيم محمد على(2) (60) منها في كتابه (المصلح المجاهد الخراساني) فضلا عما لم يشمله الحصاء أو كتب أو حشي عليها بعد استشهاد المرحوم عبد الرحيم محمد علي.
ثم ما تلا ذلك الدور من دخول النجف الجامعة مرحلة النضج المعرفي التفصيلي والتفكيكي اللاحقة.
دخلت النجف الجامعة مرحلة أكثر عمقاً وتفصيلاً وتخصصاً ودقة في بحوثها الرصينة وبخاصة في علمي الفقه وأصوله وذلك على أيدي المحققين الثلاثة الكبار وهم:
أولا: المحقق الشيخ ميرزا حسين النائيني(3) المتوفى (عام 1355 ه/ 1936م) الذي أبدع في التفكيك بين الأمارات والأصول، وتساءل عن الفرق بين المجعول في
ص: 54
أدلة حجية الأمارات وأدلة حجية الأصول ومراتب الحكم التكليفي وتقسيم الأحكام الشرعية والمعنى الحرفي والعلل الشرعية واستصحاب العدم الأزلي وغير ذلك كثير وبخاصة تحقيقاته في مباحث الصحيح والأعم ودلالة صيغة الأمر والواجب المشروط ومقدمة الواجب والتعبدي والتوصلي والنفسي والغيري واجتماع الأمر والنهي والفرق بين شرائط الجعل وشرائط المجعول والتخصص والتخصيص والحكومة والورود(1).
وكان النائيني في عصره يشار اليه بالبنان لما كان يتسم به من القدرة الفائقة على النقد والتحقيق وسلاسة البيان وعمق النظر والمنهجية في البحث(2).
أما بخصوص تضلعه في علم الأصول فأمر عظيم لأنه أحاط بكلياته ودققه تدقيقا مدهشا وأتقنه إتقانا غريبا، وقد رنّ الفضاء بأقواله ونظرياته العميقة، كما انطبقت أفكار أكثر المعاصرين بطابع خاص من آرائه حتى عد مجددا في هذا العلم، كما عدت نظرياته مماثلة لنظريات الآخند الخراساني وكان لبحثه ميزة خاصة لدقة مسلكه وغموض تحقيقاته فلا يحضره إلا ذوو الكفاءة من أهل النظر(3).
وقد أجاد كتابة تقريرات بحثه عديدون في مقدمتهم تلميذه الشيخ محمد علي الكاظمي في كتاب أسماه (فوائد الأصول) في أربعة أجزاء، وتلميذه السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي المرجع الأعلى لاحقا في كتاب أسماه (أجود التقريرات) في جزأين.
ثانياً : المحقق الشيخ أغا ضياء العراقي(4) المتوفى (عام 1361ه / 1942م) درّس السطوح العليا وخارج الفقه والأصول ستين سنة، منها أكثر من ثلاثين سنة في تدريس البحث الخارج، وعرف بكتابة محاضراته بنفسه وإن كان بلغة معقدة في كل مرة يعود فيها لإلقاء محاضراته، خلافا لعذوبة بيانه وطلاقة لسانه في التدريس، كما عرف عنه إفساحه المجال الواسع لمناقشات طلابه فسيستثمرون سعة صدره ودعابته في إغناء
ص: 55
معلوماتهم، وقد ترك لعلماء الأصول وطلاب العلم من معاصريه واللاحقين له كتابا أصوليا كاملا في أصول الفقه أسماه (مقالات الأصول) ضمنه دورة أصولية كاملة.
وقد أحسن عرض آرائه بعض تلامذته يأتي في مقدمتهم الشيخ محمد تقي البروجردي في كتابه الذي أسماه (نهاية الأفكار) وقد تطرق فيه إلى آراء أستاذه مستوعبا البحث في القطع والحجج والأصول العملية، وكذا الشيخ هاشم الآملي في كتابه (بدائع الأفكار) مستوعبا البحث في مباحث الأصول اللفظية والملازمات العقلية.
ثالثاً : المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني(1) المتوفى (عام 1361 ه / 1942م)، واضع المنهجية الشاملة لمباحث علم الأصول، وهي المنهجية التي اعتمدها وتبناها تلميذه الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه (أصول الفقه) كما سيأتي ذكرها تفصيلا في فصل لاحق.
ويعرف عن الشيخ الأصفهاني أنه وظف علم الفلسفة وهو الفيلسوف المشهود له في الأصول توظيفا واسعا بحيث تظهر آراؤه وتحقيقاته الفلسفية على جميع آثاره ودروسه حتى ليكاد المتلمذ له في الأصول خاصة يجد من نفسه أنه ألم بأكثر الأبحاث الفلسفية من حيث يدري أو لا يدري، ومن قرأ حاشيته على الكفاية بالخصوص يجد كيف تطغى المصطلحات الفلسفية على تعبيره حتى ليظن أحيانا أنه يقرأ كتابا في الفلسفة، وقد طغت روحه الفلسفية حتى على أراجيزه في مدح النبي وآله الأطهار(2).
ولقد بلغت دقة البحث الأصولي والقدرة على الاستدلال بالمنطق والقابلية الفذة على الإقناع بالدليل أوجها الرفيع عند المحققين الثلاثة حتى قال أحد الفضلاء من تلاميذ المحقق النائيني(3) لقد كنت أسمع من أستاذنا النائيني رأيا يختلف عن رأي زميله المحقق العراقي فأقتنع برأي شيخنا النائيني بشكل كامل، فإذا جلست إلى الشيخ
ص: 56
العراقي وناقشته فيه أقنعني بخلافه وقمت وأنا مقتنع بصحة رأيه وعدم صحة رأي أستاذنا الشيخ النائيني، فأرجع إلى المحقق النائيني فيعيد اليّ قناعتي الأولى القائمة على أسس متينة، فلما أعود إلى المحقق العراقي وأناقشه في المباني والأساس الذي سمعته من أستاذي زلزل قناعتي من جديد ووجدتني من جديد في حيرة من أمري. ولا تتأتى قوة الحجة هذه إلّا للقلة القليلة من أهل الرأي والحكمة والمعرفة.
وقد أعقب هؤلاء العلماء الكبار بعض من أقرانهم والعديد من فحول تلامذتهم وتلامذة تلامذتهم مما لا يسعني الوقوف عندهم جميعا لكثرتهم بيد أن ذلك لا يعفيني من الإشارة على نحو الإجمال إلى بعضهم حسب تواريخ وفيات الأقدم فالأقدم منهم على سبيل المثال لا الحصر:
1 - السيد محمد كاظم اليزدي(1) المتوفى (عام 1337ه / 1919م) الفقيه والمرجع الأعلى في عصره والمفتي بالجهاد ضد الإيطاليين والبريطانيين والروس بعد احتلالهم لبلاد المسلمين وصاحب كتاب (العروة الوثقى) المعروف في أوساط الحوزات العلمية بجمال عبارته وحسن سبكه واستيعابه للمسائل بما فيها المستحدثة منها في عصره وقد تناولته أيدي الفقهاء والعلماء بالشرح والتبيين والاستدلال. والتحشية.
2- السيد أبو الحسن الأصفهاني(2) المتوفى (عام 1365 ه/ 1946م) المرجع الأعلى في عصره والمعروف بدقة التحليل والمجاهدة والتحمل والزهد والصبر وصاحب المواقف الصلبة التي ضاق بها حكام العراق ذرعا فأمروا بنفيه إلى خارج العراق فأصدر بيانه المهم الذي ورد فيه ما نصه: من الواجبات الدينية على جميع المسلمين هي الدفاع عن الإسلام والبلاد الإسلامية، وبالخصوص،العراق، بلد المقدّسات، وبلد الأئمّة الأطهار (عَلَيهِم السَّلَامُ)، ضد تسلّط قوّات الأجانب.
حوزة النجف الأشرف
ص: 57
3- الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء(1) المتوفى (عام 1373 ه / 1954م) المرجع الكبير في عصره والمؤلف لكتاب (تحرير المجلة) في خمسة أجزاء وهو شرح مزجي على (مجلة الأحكام العدلية) ذلك الكتاب الذي يمثل تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على شكل مواد قانونية حيث جرى تطبيق أحكام هذه (المجلة) في المحاكم المدنية في كافة البلدان التابعة للحكم العثماني آنذاك، وقد شرح الشيخ بعض بنود (مجلة الأحكام العدلية) وأوضح قواعدها وفروعها في ضوء الفقه الجعفري مناقشا الكثير مما جاء في (مجلة الأحكام العدلية) بما ينبيء بوضوح عن مدى تقدم البحث الفقهي الأصولي في حوزة النجف الأشرف عن غيره من المدارس الفقهية الأخرى التي أغلقت على نفسها أبواب الاجتهاد.
4 - الشيخ محمد رضا المظفر(2) المتوفى (عام 1383 ه/ 1963م) المفكر المجدد وأول عميد لكلية الفقه في النجف الأشرف والمؤلف لكتابي : (المنطق) الذي أغنى أو كاد عما قبله من كتب المنطق الدراسية في الحوزات العلمية، و (أصول الفقه) الجديد في طرحه، الواضح في عبارته المنهجي في تبويبه كما سيأتي ذلك لاحقا.
5- السيد محسن الحكيم(3) المتوفى (عام 1390 ه / 1970م) المرجع الأعلى في عصره ومؤلف كتاب (المستمسك في شرح العروة الوثقى) في (14) جزء والزاخر بمجلداته بآخر ما توصلت اليه حوزة النجف الأشرف العلمية حتى عهده من آراء ونظريات في علوم الفقه و أصوله وكل ما يمت إلى علوم الشريعة بصلة مما حدا ببعض الكتاب(4) لأن يصف المستمسك بأنه الموسوعة الفقهية القيّمة التي لم يسمع بمثلها في هذا الدور من حيث الترتيب والتنظيم والتحقيق والدقة وقوة الاستدلال والتلخيص. هو أول كتاب فقهي ظهر للملأ العلمي بهذا الشكل الكامل في جميع الأبعاد ولم يسبقه أحد من فقهائنا الأفذاذ في هذا الدور وأحرز مؤلفه (قدّس سِرُّه) بهذا التأليف مقام القيادة الكبرى
ص: 58
لركب المحققين حيث أنه يرجع كل تحقيق في شرح العروة الوثقى من بعد صدور هذا الكتاب (المستمسك) إلى ما حققه المؤلف فيه. وكل ما جاء بعده من شروح العروة الوثقى فقد وجد طريقا معبدا فسار عليه بسهولة.
6 - الشيخ حسين الحلي المتوفى(1) ( عام 1394ه / 1974م) أستاذ العديد من المراجع والعلماء والمتعق في بحث المسائل الفقهية والأصولية الشائكة والمتصدي مبكرا للبحث في المسائل المستحدثة المستجدة في عالم اليوم تلك التي تحتاج إلى بحث وتأصيل فقهي و أصولي لتحديد الموقف الشرعي منها، وقد دون تقريراته تلك سماحة الشهيد السيد عز الدين بحر العلوم في كتابه الموسوم ( بحوث فقهية) من محاضرات أستاذه الشيخ الحلي (قدّس سِرُّه).
7- السيد محمد باقر الصدر(2) المستشهد (عام 1400 ه / (1980م) المرجع المجدد والمؤلف لكتابي: (دروس في علم الأصول) الذي سيأتي الحديث عنه لاحقا، و(الأسس المنطقية للاستقراء) من خلال صياغة مذهب جديد في تفسير كيفية نمو المعرفة البشرية وتوالدها، عبر عن اتجاه آخر في تفسير المعرفة البشرية غير ما كان معروفا بين المذهبين التجريبي والعقلي وهو ما اصطلح عليه بالمذهب الذاتي للمعرفة (3).
8- السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي(4) المتوفى (عام 1413ه / 1992م) المرجع الأعلى في عصره وواضع منهجية تألفت من خصائص متعددة قسم من خلالها المباحث الأصولية أسوة بأستاذه الشيخ النائيني إلى أقسام أربعة:
أولها: ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني.
وثانيها : ما يثبت الحكم الشرعي بعلم جعلي تعبّدي وهو يتضمن مباحث الألفاظ
ص: 59
وحجية الظواهر.
وثالثها ما يعيّن الوظيفة العملية الشرعية.
ورابعها ما يعيّن الوظيفة العملية بحسب حكم العقل. ثم قال: فهذا كله فهرس المسائل الأصولية وترتيبها الطبيعي(1).
كما ألّف سماحته (قدّس سِرُّه) بين كتاب (معجم رجال الحديث) في أربعة وعشرين مجلدا، وهو المصنف المهم في استيعابه وحسن تبويبه وجدته في الطرح والمعالجة: بما وضع من أسس علمية رصينة في علم الحديث والرواية من جهة وفن علم الرجال وسنن الجرح والتعديل من جهة أخرى وما اضافه من نظام القبول والرفض للروايات وما بينه من توثيق الرواة أو ردّهم وما سجله من عدد الروايات وأماكنها من الكتب ومظاتها في الموسوعات الحديثية(2).
9 - السيد محمد تقي الحكيم(3) المتوفى (عام 1423ه/ 2002م) المفكر المجدد والعميد الثاني لكلية الفقه في النجف الأشرف والمؤلف لكتابي: (الأصول العامة في الفقه المقارن) الرائد والمرجع الأهم في الدراسات الأصولية المقارنة كما سيأتي، و(عبد اللّه بن عباس حياته وآثاره) الكتاب التحليلي لخلفيات ما جرى قبل وبعد وفاة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) من تداعيات مؤسفة أدت فيما أدت اليه من خروج على النص..
وهناك عدد كبير من غير هؤلاء العلماء الأعلام والمجتهدين المجددين ممن خرجتهم حوزة النجف الأشرف أصبح غالبيتهم مراجع تقليد للمؤمنين لا يمكنني تبيان أدوارهم وأسمائهم جزاهم اللّه عن الإسلام والمسلمين خيرا وحشرهم بما قدموه لفقه محمد وآل محمد مع محمد وآل محمد في أعلى عليين..
ص: 60
هذا وقد استعرض الشيخ محمد مهدي الآصفي(1) الحلقات المتعاقبة لتكامل المنهج العلمي لعلم أصول الفقه خلال هذه الأطوار ابتداء من كتاب (فرائد الأصول) للشيخ الأنصاري إلى كتاب (الأصول العامة للفقه المقارن) للسيد محمد تقي الحكيم في سبع حلقات فكانت كالتالي:
* الحلقة الأولى : منهجية المحقق الشيخ مرتضى الأنصاري (قدّس سِرُّه).
* الحلقة الثانية في المنهجية : تعديل المحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني (قدّس سِرُّه).
* الحلقة الثالثة : دور المحقق الشيخ محمد حسين النائيني في التفكيك بين الإمارات والأصول (قدّس سِرُّه).
* الحلقة الرابعة : منهجية المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني (قدّس سِرُّه).
* الحلقة الخامسة : منهجية المحقق السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه).
* الحلقة السادسة منهجية المحقق السيد محمد باقر الصدر (قدّس سِرُّه).
* الحلقة السابعة وهي الأخيرة منهجية المحقق السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه).
ثم من من أعقب هؤلاء المصلحين والفقهاء من مراجع التقليد اليوم وزعماء حوزتها العلمية الحالية في النجف الأشرف المتصدين للبحث والتحصيل والعلم ولهموم العراق والأمة في آن واحد الحاضرين في عقول وقلوب وأفئدة المؤمنين دوما بما يغني عن الذكر والتبيان وهم كل من : أصحاب السماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، والمرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، والمرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض والمرجع الديني الشيخ بشير النجفي (دام ظلهم)، ثم من أعقبهم من أساتذة البحث الخارج والسطوح العالية المعاصرين في حوزة النجف الأشرف اليوم ممن يرجى لهم التقدم في مضمار البحث العلمي والتحصيل وصولا إلى
ص: 61
المراتب العالية مستقبلا أخذ اللّه بأيديهم جميعا لما يحبه ويرضاه.
وسأتناول بتفصيل أكثر عصور البحث الفقهي / الأصولي في حوزة النجف الأشرف في كتابي الثاني عن حوزة النجف الأشرف الموسوم (حوزة النجف الأشرف: عصورها العلمية وعلماؤها المعاصرون).
ولا يفوتني وأنا في ختام حديثي عن حوزة النجف الأشرف أن أشير إلى غنى وعمق وثراء وجدة وأصالة ما قدمته الحوزة العلمية في النجف الأشرف في غير مجالي علم الفقه و أصوله من كتب ورسائل وبحوث وتصانيف وآراء ونظريات في مجالات علمية وأدبية عديدة أخرى كالتفسير والحديث والتاريخ والتراجم والسير والفلسفة والحكمة والكلام والأخلاق واللغة والأدب العربي بشعره الغزير ونثره وغير ذلك من المعارف والعلوم الإنسانية الأخرى مما لا يسع المجال للتنويه بها في هذا الموجز قد ساهمت جميعها بشكل فاعل في تقدم البحث المعرفي في حاضرة النجف الأشرف العلمية رغم حملات التصفية والإلغاء والحصار والكبت والتضييق والمطاردة والخنق بما لا يلم بأطرافه كتاب مختصر ككتابي هذا.
إن كل هذا الغنى الفكري والتنوع المعرفي والتراكم العلمي قد ترك بصماته واضحة على حاضر هذه الجامعة العلمية العريقة ومستقبلها الواعد المنتظر.
ص: 62
(1) سورة التوبة: آية 122
(2) الشيخ الطوسي (385 - 460 ه) / (995 1068م) تلميذ الشريف المرتضى وفقيه الشيعة ومتكلمها وشيخها في عصره. درّس في داره بالمحلة المعروفة بمحلة المشراق اليوم في النجف وتوفي ودفن فيها بعد أن تولى غسله وتكفينه ودفنه تلميذه الشيخ الحسن بن مهدي السليقي والسيخ الحسن بن عبد الواحد العين زربي والشيخ اللؤلؤي، وقد حولت داره بعد مدفنه فيها مسجدا يسمى باسمه في الشارع الذي يسمى اليوم باسمه أيضا قرب باب الصحن العلوي المسماة باسمه كذلك. له من الكتب المطبوعة غير ما تقدم كثير منها: التهذيب في 10 أجزاء، والاستبصار في 4 أجزاء والتبيان في تفسير القرآن في 12 جزء، تلخيص الشافي في 4 أجزاء. الفهرست الخلاف المبسوط الاقتصاد. مصباح المجتهد النهاية. الغيبة.
(3) معجم البلدان 2 / 342.
(4) ينظر : تاريخ التشريع الإسلامي د. الشيخ عبد الهادي الفضلي : 403
(5) الدور الأول لجامعة النجف. بحث للشيخ محمد جواد الفقيه. موسوعة النجف الأشرف : 6 / 110
(6) التدريس في النجف. د. الشيخ عبد الهادي الفضلي دائرة المعارف الإسلامية الشيعية سابق 10 / 374.
ص: 63
(7) الشيخ إغا بزرك الطهراني في مقدمة تفسير التبيان.
(8) لسان الميزان 2/ 350
(9) الشيخ إغا بزرك الطهراني في مقدمة تفسير التبيان
(10) تدل كلمات رجال العلم وأهل التاريخ على علو شأنه وسمو مكانه وقد أحيى ذكر أبيه وحاز المرجعية والثقة عند الطائفتين فهو إمام وابن إمام وأبو إمام واستمر العلم والحديث في بيته عشرات من الأعوام، روى عن والده وجماعة من معاصريه وقد روى عنه كثيرون (ينظر : ماضي النجف وحاضرها. سابق: 2 / 474 -475.
(11) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي: 4 / 126
(12) سياسي بارز وثائر من كبار الثوار ضد الاحتلال الإنكليزي للعراق سنة (1332 ه / 1914م) وبعدها ومن مشاهير الأدباء والشعراء والمؤرخين العراقيين، ولد في النجف الأشرف وتتلمذ على يد المرجع الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية، شغل عدة مناصب تشريعية وتنفيذية متقدمة في البرلمان العراقي والحكومة. من كتبه المطبوعة : مؤرخ العراق ابن الفوطي، ابن خلكان وفن الترجمة أصول ألفاظ اللهجة العراقية، بين مصر والعراق، تراثنا الفلسفي، لهجات الجنوب التربية في الإسلام ديوان شعر كبير.مذكرات مهمة تؤرخ لثورات النجف وثورة العشرين وغيرها نشر قسم منها في دورية عراقية.
(13) محمد بن أبي القاسم الطبري المعروف بعماد الدين الطبري ترعرع في أسرة علمية تضم العلماء و المجتهدين، فوالده أبو القاسم محمد بن علي من علماء الشيعة الكبار وكذلك جده يعد من أعلام الشيعة ووجهائها. كان على قيد الحياة
ص: 64
إلى سنة (553 ه- / 1158م) بدأ دراسته في الحوزة العلمية في مدينة النجف الأشرف فحضر دروس كبار العلماء من أمثال أبي علي الطوسي ابن الشيخ الطوسي و تلقى منهم العلوم والمعارف الإلهية حتى وصل إلى أعلى درجات العلم والاجتهاد ثم شرع بالتدريس وتربية الطلاب من الناحية العلمية و الأخلاقية يأتي في مقدمتهم سعيد بن هبة اللّه الراوندي المعروف بقطب الدين الراوندي ومحمد بن جعفر المشهدي مؤلف كتاب المزار المعروف. من أهم مؤلفاته : بشارة المصطفى صلى اللّه عليه وآله لشيعة المرتضى عليه السلام وهو أشهر كتاب للطبري ويقع في 17 جزءا ولكن الذي وصل إلينا منها 10 أجزاء وضاع الباقي. وله أيضا كتاب الزهد و التقوى. و شرح مسائل الذريعة الذي هو من تأليف السيد المرتضى علم الهدى المتوفى سنة (436ه- / 1044م) وغيرها
(14) محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي المتوفى سنة (598ه/ 1202م) الفقية الجريء الذي استطاع أن يتخطى النظر إلى ما قيل بدلا عن النظر إلى من قال كاسرا هيبة النقد العلمي لآراء الشيخ الطوسي التي بقيت مسيطرة حتى جاء ابن إدريس ففتح باب النقاش العلمي وإن معها مجددا رافضا العمل بخبر الواحد غير المحفوف بالقرينة حاذيا حذو الشيخ المفيد والسيد المرتضى بيد أن مذهب الشيخ الطوسي العامل بخبر الواحد المعتبر وإن لم يكن محفوفا بالقرينة هو المذهب المعتمد عليه إلى اليوم. من أهم كتبه السرائر.
(15) هو الشيخ سديد الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصي الحلّي الرازي. كان على قيد الحياة سنة (600 ه / 1204م)، أصولي فقيه ومناظر قوي الحجة والبيان وشاعر وأديب، روى عنه عدد من المشايخ منهم: الشيخ ورّام بن أبي
ص: 65
فراس له مؤلفات كثيرة منها : (المصادر في أصول الفقه)، و(نقض الموجز)، و (التبيين والتنقيح)، و ( بداية الهداية)، و (الأمالي العراقية) و(التعليق الكبير)، و (التعليق الصغير).
(16) ولد سنة (757ه / 1356م) - في الحلة وتتلمذ على يد أكابر العلماء أمثال الشيخ علي بن الخازن الحائري والشيخ أبي الحسن علي بن الشهيد الأول، وروى إجازة وقراءة عن الفاضل المقداد السيوري وابن المتوج البحراني وغيرهما. بقي فترة مدرسا في المدرسة الزينبية في الحلة السيفية، ثم انتقل إلى كربلاء فازدهرت بانتقاله الحركة العلمية فيها، عرفت عنه رياضته وعبادته ومناظراته ومن أهمها تلك التي وقعت في زمان الميرزا أسبند التركماني الذي كان واليا على العراق حيث تصدى ابن فهد لإثبات مذهبه وإبطال مذهب غيره من المناظرين له في مجالس الميرزا التركماني المذكور فغلب جميع علماء العراق، فانتقل الميرزا المذكور إلى مذهبه وجعل السكة والخطبة باسم أمير المؤمنين وأولاده الأئمة الأحد عشر (عَلَيهِم السَّلَامُ) ويبدو أن المناظرة فقدت حيث لم يعثر لها على أثر إلى الآن حسب علمي، تتلمذ على يدي ابن فهد العديد من العلماء أبرزهم الشيخ علي بن هلال الجزائري: وهو من أجلة تلامذته وأستاذ الشيخ الكركي، دفن ابن فهد بكربلاء، وبجنبه شارع باسمه وقبره اليوم مدرسة علمية.
(17) شاع في كتابات العديد من الباحثين الذين أرخوا للحوزة العلمية أنها انتقلت عن مدينة النجف الأشرف إلى غيرها ثم عادت مجددا إلى النجف بيد أن عملية الانتقال هذه والعودة منها إلى النجف ثانية والأدلة التي تساق للتدليل عليها تبدو لي غير مقنعة، فأنا ميّال إلى أن فتورا علميا كان يعتري الحوزة العلمية النجفية لأسباب عديدة مترافقا مع نشاط علمي ملحوظ في حوزات علمية في
ص: 66
مدن أخرى في الفترة نفسها هو ما كان يوحي للباحثين بانتقال الحوزة العلمية عن النجف وعودتها اليها مجددا. ولعلى أوفق للتدليل على ما ذهبت اليه في مجال آخر.
(18) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. السيد حسن الأمين: 371/10-372.
(19) ينظر : مع علماء النجف الأشرف. السيد محمد الغروي 1/ 108. و 1/ 162 و 1/ 176 – 177 و 1 / 195 و 1 / 217 و 1 / 257.
(20) ينظر المصدر السابق: 1/ 349 و 1 / 466 - 1747 و 12 / 49 - 583.
(21) الحسن بن يوسف من كبار علماء الإمامية وبخاصة في الفقه حيث ألف العديد منها ما بين موسع ومتوسط ومختصر أشهرها المختلف والتذكرة والمنتهى والقواعد والتحرير وتبصرة المتعلمين ألف في الفقه المقارن كما فعل الشيخ الطوسي والمحقق الحلي، كان له باع مشهود في علم الأصول حيث ألف فيه كتبا متدرجة من أهمها نهاية الوصول إلى علم الأصول وتهذيب الوصول إلى علم الأصول ومبادئ الوصول إلى علم الأصول، وقد برع إضافة لذلك في العلوم العقلية والفلسفة فناقش معاصره الشهير في العلوم العقلية الشيخ نصير الدين الطوسي بل والرئيس ابن سينا وله في فن المناظرة والجدل وعلم الكلام كتب عديدة. وقد أوصل بعض المحققين تأليفه ورسائله إلى ما أربى على المائة. وقد اشتهر بتشيع السلطان محمد خدابنده على يديه.
(22) توفي في النجف ودفن في الحجرة المتصلة بالرواق في الصحن العلوي الشريف. درس العلوم العقلية بشيراز ثم اقتصر في دراسته على النقليات من أواسط عمره حتى توفي له من الكتب آيات الأحكام. أصول الدين. إثبات الواجب حاشية شرح التجريد. حديقة الشيعة مجمع الفائدة والبرهان في
ص: 67
شرح إرشاد الأذهان وقد يسمى بحاشية الإرشاد أو مجمع الفائدة أو مجمع البرهان وللشيخ هالة قدسية خاصة مكنته من احتلال قلوب المؤمنين وفرضت له احتراما بالغا وتبجيلا في قلوب سلاطين عصره.
(23) ينظر : تاريخ التشريع الإسلامي. الدكتور عبد الهادي الفضلي : 89 وكذلك : تاريخ وتطور الفقه والأصول في حوزة النجف الأشرف العلمية. السيد محمد جعفر الحكيم : 113 وما بعدها.
(24) تاريح وتطور الفقه والأصول في حوزة النجف الأشرف سابق : 115.
(25) المصدر السابق : 115-116.
(26) علي بن الحسين بن موسى، ولد سنة 355 ه تلميذ الشيخ المفيد والمتأثر بمنهجه الفكري. تولى نقابة الطالبيين وإمارة الحاج والمظالم بعد أخيه الشريف الرضي وأبيه. برع في علوم عدة من أهمها الفقه والكلام و أصول الفقه والشعر والأدب، نشّط نوادي العلم وأوقف قرية على تأمين الورق للفقهاء للكتابة والاستنساخ. من مؤلفاته الكثيرة : الانتصار فيما اختلف فيه الإمامية وغيرهم. الذريعة إلى أصول الشيعة في علم أصول الفقه الناصريات رسائل السيد المرتضى. وله ديوان شعر مطبوع.
(27) تقدم التعريف به في متن الكتاب.
(28) يرتفع نسبه إلى مدينة تون قرب مدينة قائن، وهي منطقة في مقاطعة خراسان جنوب شرق مشهد الإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)، سكن اصفهان أول الأمر ثم استقر في مشهد الإمام الرضا بخراسان ومنها قصد العراق للزيارة. اهم كتبه الوافية: وهو من كتب الأصول المهمة، وقد شرحه السيد صدر الدين القمي المتوفى سنة (1170 ه- / 1757م) ورغم أن هذا الكتاب قد ألف بعد كتاب المعالم
ص: 68
وحوى تقسيما ملفتا للنظر مضيفا فيه جديدا على من سبقه من الأصوليين كالعلامة الحلي والمحقق والطوسي والمرتضى إلّا أنه لم يحظ بالاهتمام بمثل ما حظي به كتاب المعالم. وكان الشيخ زاهدا عابدا، توفي في كرمانشاه ودفن فيها.
(29) مقدمة تحقيق كتاب الوافية في أصول الفقه. السيد محمد حسين الرضوي الكشميري: 27.
(30) ولد بقرية دوان سنة ( 820 ه- / 1417م) وسكن مدينة شيراز وقد استطاع بفضل نبوغه المبكر إلى الترقي في مدارج العلم والحكمة سريعا فنال احترام الأقربين والأبعدين. عين قاضي القضاة في مملكة فارس وجال في البلدان العربية واستوطن النجف الأشرف فترة من الزمن. توفي في مسقط رأسه دوان ودفن بها وقد علت قبره قبة إلى جانبها منارة من كتبه: التوحيد حل مغالطة ابن كمونة. استكاكات الحروف.
(31) لمحة من مسيرة مدرسة النجف الفلسفية. الشيخ عبد الجبار الرفاعي بحث مجلة الفكر الإسلامي. العدد 12 لسنة (1416 ه- / 1995م) ص 139 نقلا عن الضياء اللامع في القرن التاسع للشيخ أغا بزرك الطهراني: 33 والذريعة إلى تصانيف الشيعة له أيضا : 12 / 63.
(32) ينظر : معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام. د. الشيخ محمد هادي الأميني: 2/ 577.
(33) أحد أبرز اساتذة الفلسفة والحكمة في النجف في القرن العاشر و أستاذ صاحب المعالم وصاحب المدارك في المعقول من اشهر كتبه العديدة كتاب (حاشية ملاعبد اللّه) على كتاب التهذيب في علم المنطق للتفتازاني الذي انتهى من تأليفه في سنة (967 ه- / 1560م) جوار الحضرة العلوية المشرفة، فقد
ص: 69
استحوذ هذا المؤلف على حلقات درس هذا العلم وتدريسه في حوزة النجف والحوزات العلمية الأخرى منذ عصر مؤلفه واشتهاره وحتى ظهور وانتشار كتاب المنطق للشيخ محمد رضا المظفر له من المؤلفات الأخرى: حاشية على شرح الشمسية، حاشية على مبحث الجواهر من شرح التجريد و شرح العجالة وهو حاشية حاشية الدواني.
(34) مجتهد معروف بالفضل والعلم والتقوى والزهد والورع حتى لقب بالمقدس، قرأ العلوم الشرعية على أكابر علماء عصره وقرأ العلوم العقلية على يد المولى جمال الدين محمود تلميذ جلال الدين الدواني المعروف بالدقة العقلية، تخرج على يديه العديد من العلماء والباحثين وقد اقتصر في أواسط عمره على النقليات إلى أن توفى بعد أن عزف عن العلوم العقلية التي برع فيها قبل ذلك.توفي في النجف الأشرف ودفن بالرواق العلوي المطهر. له من التصانيف: غير ما تقدم: أصول الدين استيناس المعنوية، حاشية شرح التجريد للقوشجي، حديقة الشيعة، حاشية شرح مختصر الأصول، الخراجية، وغيرها.
(35) ولد الشيخ في الجزائر وهي ناحية قرب محافظة البصرة ونشأ نشأة علمية في النجف الأشرف حيث تلقى علومه على أبرز علمائها وفقهائها ومدرسيها ثم توجه إلى كربلاء المقدسة ليعيش فيها بقية عمره الشريف عرف باهتمامه الكبير بعلم الرجال والحديث والفقه. له من الكتب إضافة لما تقدم مؤلفات في الفقه والعقائد والحديث.
(36) كتابة التاريخ في النجف في العصر العثماني. د. عماد عبد السلام رؤوف. بحث ضمن بحوث كتاب مدرسة النجف الأشرف ودورها في إثراء المعارف الإسلامية: 144. من تلاميذ المقدس الأردبيلي ومن أسرة علمية معروفة فقد
ص: 70
كان والده من أكابر العلماء كذلك. تصدى الأمير فيض اللّه للتدريس فتخرج على يديه ثلة من العلماء والفقهاء،والمتكلمين حاز قصب السبق في علوم عديدة في مقدمتها الفقه والحكمة وعرف بالصلاح والتقوى ولين العريكة ودماثة الخلق والسبق إلى الفضيلة له من الكتب غير ما تقدم: حاشية المختلف، فوائد متفرقة في تحقيق مسائل أصول الفقه، أصول الأحوال القمرية في شرح الإثني عشرية وغيرها..
(37) من تلاميذ المقدس الأردبيلي ومن أسرة علمية معروفة فقد كان والده من أكابر العلماء كذلك. تصدى الأمير فيض اللّه للتدريس فتخرج على يديه ثلة من العلماء والفقهاء،والمتكلمين حاز قصب السبق في علوم عديدة في مقدمتها الفقه والحكمة وعرف بالصلاح والتقوى ولين العريكة ودماثة الخلق والسبق إلى الفضيلة له من الكتب غير مكا تقدم: حاشية المختلف، فوائد متفرقة في تحقيق مسائل أصول الفقه، أصول الأحوال القمرية في شرح الإثني عشرية وغيرها.
(38) ينتهي نسبه إلى الحسن المثنى ابن الإمام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ). جد الأسرة العلمية (آل الحكيم) وكان معروفا بالعلم والحكمة والفضل والموسوعية إلا أنه تميز بعلم الطب والأدوية وتمرس بهما فطارت شهرته في البلدان فاختير طبيبا خاصا للشاه عباس الصفوي، وحين غادر الشاه عباس النجف الأشرف بعد زيارته لها بقي السيد علي الحكيم في النجف الأشرف يعالج مرضى المدينة المقدسة حتى توفي فيها ودفن في ترابها الطاهر.
(39) من الفقهاء والمجتهدين العاملين عني بالحديث والرجال واللغة والشعر إضافة إلى الفقه و أصوله وعرف بالزهد والعبادة. ويعد كتابه مجمع البحرين ومطلع
ص: 71
النيرين من الكتب الفريدة في بابها، ويقع في 5 أجزاء، وله من الكتب المطبوعة غيره من أهمها : جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال. وضوابط الأسماء. ومنتخب المراثي والخطب ونزهة الخاطر وسرور الناظر وتحفة الحاضر. وله العديد من المخطوطات التي لم تطبع. توفي عن مكتبة عامرة فقد الكثير من كتبها المخطوطة والمطبوعة بعد وفاته.
(40) ماضي النجف وحاضرها. سابق : 2/ 456. وينظر : كتابة التاريخ في النجف في العصر العثماني : سابق : 145 - 147
(41) من كبار تلامذة السيد صاحب المدارك والشيخ البهائي والشيخ حسن صاحب المعالم، ومن أهل الفضيلة والعلم والتحقيق المعروفين في عصره سافر سنة 1004ه إلى المشعشعيين ليحيطهم علما بمذهب أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) من مؤلفاته الأخرى عدا ما ذكر: جامع الأخبار في أيضاح الاستبصار، وكتاب في علم المنطق، وحاشية على كتاب معالم الدين ورسالة صغيرة في مسألة الاجتهاد والتقليد.
(42) ماضي النجف وحاضرها. سابق : 3 / 321.
(43) من علماء الأنساب المشهورين بالإحاطة والدقة، تولى أمر خزانة المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف فعمل على تنظيمها وترتيبها وصيانتها وحفظها كما استفاد بدوره من غناها بالكتب العلمية وبخاصة التاريخية منها.
(44) من الفقهاء المحقّقين والمحدثين، كتب له العلامة المجلسي إجازتين، كتب في علوم عديدة منها: التفسير والفقه والرجال وعلم الكلام و أصول الفقه وغيرها فأجاد فيها، له من الكتب غير ما تقدم: مرآة الأنوار في التفسير. الصحيفة السجادية. شرح على كفاية السبزواري. شريعة الشيعة: وهو شرح على
ص: 72
مفاتيح الملا محسن الفيض رسالة في حقيقة مذهب الإمامية وبيان أساسه. وغيرها.
(45) يقول الشيخ محبوبة : توجد نسخة نفيسة تمتاز بالضبط والإتقان عند الشيخ محمد حسن ابن الشيخ محسن الجواهري (ماضي النجف وحاضرها. سابق : 3 / 46)
(46) من الفقهاء والمحققين ومن أساتذة الحديث والتفسير في حوزة النجف الأشرف ويعد من مشايخ الإجازة المعروفين. جمع في حياته مكتبة عامرة بالمخطوطات النادرة تفرقت بعد وفاته بين ورثتهم ولم يعد لها أثر.له العديد من المؤلفات غير ما تقدم منها : ارتداد الزوجة. شرح تهذيب العلامة الحلي. آداب المناظرة.
(47) أديب شاعر وكاتب من معاصري السيد نصر اللّه الحائري وقد مدحه معاصره الشيخ أحمد النحوي بقصيدة له من الكتب: بحر الأنساب، وشرح نهج البلاغة، والريحانة في النحو، وديوان شعر وغيرها.
(48) ولد الشيخ النراقي في حدود عام (1128 ه / 1716م) في مدينة نراق وهاجر إلى العراق فتلقى علومه على عدد من العلماء في مقدمتهم الوحيد البهبهاني. ثم رجع إلى كاشان فكتب فيها كتابه (جامع الأفكار وناقد الأنظار) في الفلسفة ثم هاجر إلى العراق ثانية ليتوفى في النجف الأشرف وليدفن خلف الحرم العلوي المطهر.
(49) من أبرز مراجع التقليد في القرن الثالث عشر. عدت مرجعيته الدينية نقطة انعطاف في تطور الحوزة العلمية في النجف فقد انتجت دراسته التحليلية للرجال والحديث تصحيح الكثير من الروايات التي كانت فيما بعد أساسا أدى إلى تحول واضح في مجال الاستنباط خلق روحا جديدة فيه أدت فيما بعد
ص: 73
إلى ما أدت اليه بعده والى اليوم وفيما بعد من ثمار غاية في الأهمية في مستقبل حوزة النجف. درّس المعالم عشرين دورة وكان يدون حاشية جديدة في كل مرة. يقول محمد حسين الكرهرودي: شاهدت في مدينة بروجورد 19 نوعا منها. من مؤلفاته الاجتهاد والأخبار. شرح مفاتيح الفيض. حاشية على المعالم. دفن في الرواق الحسيني من حضرة الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كربلاء المقدسة بعد أن عمّر قرابة المائة عام.
(50) من أبرز مراجع التقليد في القرن الثالث عشر. عدت مرجعيته الدينية نقطة انعطاف في تطور الحوزة العلمية في النجف فقد انتجت دراسته التحليلية للرجال والحديث تصحيح الكثير من الروايات التي كانت فيما بعد أساسا أدى إلى تحول واضح في مجال الاستنباط خلق روحا جديدة فيه أدت فيما بعد إلى ما أدت اليه بعده والى اليوم وفيما بعد من ثمار غاية في الأهمية في مستقبل حوزة النجف. درّس المعالم عشرين دورة وكان يدون حاشية جديدة في كل مرة. يقول محمد حسين الكرهرودي: شاهدت في مدينة بروجورد 19 نوعا منها. من مؤلفاته: الاجتهاد والأخبار. شرح مفاتيح الفيض حاشية على المعالم. دفن في الرواق الحسيني من حضرة الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كربلاء المقدسة بعد أن عمّر قرابة المائة عام.
(51) تطور الدرس الأصولي في مدرسة النجف الأشرف. السيد منذر الحكيم. بحث مجلة الفكر الإسلامي : العدد 16/ 117.116.
(52) ينظر: مقدمة الشيخ محمد مهدي الآصفي الواسعة لكتاب الفوائد الحائرية الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي في قم المقدسة المعنونة دور الوحيد البهبهاني في «تجديد علم الأصول».
ص: 74
(53) يرتفع نسبه إلى السيد إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط (عَلَيهِ السَّلَامُ) ابن الإمام علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ).من كبار الفقهاء والمجتهدين المحققين لقب ببحر العلوم لغزارة علمه وعمق تفقهه في علوم الشريعة. له العديد من المؤلفات غير ما تقدم منها: الدرة النجفية. ومشكاة الهداية تحفة الكرام. الفرق والملل. شرح باب الحقيقة والمجاز. وله أيضا ديوان شعر كبير.
(54) في الأدب النجفي قضايا ورجال. محمد رضا القاموسي: 155-156.
(55) من زعماء الحوزة العلمية المشهورين الذين امتدت زعامتهم الدينية إلى الأقطار المختلفة. ولد في النجف الأشرف وتوفي فيها. دافع عن مدينة النجف الأشرف دفاعا مستميتا ضد الغزاة وكانت داره مشجبا للأسلحة وثكنة للجنود والمتطوعين ضد غارات الوهابيين التي حاولت مرارا اقتحام النجف والفتك بها وبأهلها، فأعد العدة للدفاع بحمل أهل العلم والنجفيين على التدريب على حمل السلاح، وقد باشر ذلك بنفسه ومعه أولاده. له العديد الكتب من غير ما تقدم منها : منهج الرشاد لمن أراد السداد في الرد على الوهابية جوابا على رسالة وردته من الأمير الشيخ عبد العزيز بن سعود أمير آل سعود في دولتهم الأولى والمتوفى سنة (1179 ه/ 1765م). إثبات الفرقة الناجية من بين الفرق الإسلامية. بغية الطالب في معرفة المفروض والواجب. أحكام الأموات. العقائد الجعفرية. غاية المأمول في علم الأصول. مشكاة المصابيح. مناسك الحج.
(56) مرجعية التقليد 3. محمد إبراهيم جناتي دائرة المعارف الإسلاميّة الشيعية المجلد: 10 / 133.
ص: 75
(57) العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية. الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء: 57
(58) من طلاب المجتهدين الكبيرين الوحيد البهبهاني المتقدم ذكره والشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة. جمع فأحسن الجمع بين الفقه و أصوله والأدب والشعر. طبع له ديوانا شعر رائق.
(59) من طلاب الشيخ الوحيد البهبهاني بذل جهودا كبيرة في تطوير البحوث الاجتهادية وتميز بذاكرة قوية وشجاعة في صد هجمات الوهابيين واصدر رسالة في ذلك.له من الكتب غير ما تقدم شرح لوافية الأصول للفاضل التوني. حاشية على تهذيب الأصول للعلامة الحلي. تعليقة على كتاب معالم الأصول.
(60) أصولي بارع غير أنه مقل في التصنيف. عرف بشدة ذكائه وسعة علمه وكثرة تتبعه حتى عده البعض من نوابغ الحوزة. من خيار تلامذته: الشيخ علي كاشف الغطاء أستاذ الشيخ مرتضى الأنصاري.
(61) من خريجي مدرسة الوحيد البهبهاني أيضا. تخرج على يديه العديد من الفقهاء. نال قسطا من المرجعية بعد وفاة خاله الوحيد البهبهاني. ترك ثروة علمية كبيرة من الكتب والمؤلفات أحصى السيد محسن الأمين منها في كتابه القيم أعيان الشيعة 19 مؤلفا اشهرها كتابه رياض المسائل المتقدم ذكره. دفن في مشهد الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلى جوار خاله الوحيد البهبهاني.
(62) من كبار مشاهير الفقهاء والمجددين في أبحاث الفقه عند الإمامية وصاحب التقسيم الرباعي لعلم الفقه حيث بوب علم الفقه إلى: العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام كما سعى إلى تجديد تبني طريقة الشيخ الطوسي بعد
ص: 76
أن تعرضت للنقد على يد ابن إدريس الحلي. تولى الزعامة العلمية والدينية للشيعة الإمامية في الحلة الفيحاء حاضرة الحوزة العلمية في عصره له من الكتب الكثير من أهمها عدا المختصر النافع الذي أشرت اليه في المتن كتاب: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام والمعتبر ومعارج الأصول ونهج الوصول إلى معرفة الأصول ونكت النهاية.
(63) تاريخ وتطور الفقه والأصول في حوزة النجف الأشرف العلمية. سابق : 124
(64) من وجوه تلاميذ الوحيد البهبهاني أيضا والمقصود بدليل الانسداد الذي تبناه في كتابه القوانين هو : حكم العقل بلزوم العمل بالظن في الأحكام الشرعية معتمدا على مقدمات ساقها في كتابه بيد أن المحققين وفي مقدمتهم الشيخ الأنصاري ناقشوه وفندوه.
(65) من طلاب مدرسة الوحيد البهبهاني والمعروفين بالتحقيق في مضمار علم الأصول. اشتهر بحسن بيانه وإعداده لدروسه ومحاضراته في الفقه. من أشهر تلامذته السيد عبد اللّه شبر. والشيخ محمد تقي الأصفهاني وغيرهم
(66) من المحققين البارعين في علم الأصول أيضا ومن طلاب السيد محسن الأعرجي والسيد محمد مهدي بحر العلوم وغيرهما. كان مقررا لبحوث السيد بحر العلوم. خصه الشيخ جعفر كاشف الغطاء بعلاقة خاصة حيث زوجه ابنته. عاد من النجف إلى أصفهان فكان أستاذها الأكبر في عصره.
(67) مرجعية التقليد / 3 سابق : 136.
(68) ولد في النجف الأشرف وتلقى علومه فيها على يد السيد بحر العلوم حتى بلغ مرتبة الاجتهاد وهو دون الخامسة والعشرين من العمر وصنف بعض كتبه وهو دون هذه السن ويعد في علمه من طبقة الشيخ محسن الأعسم والشيخ علي
ص: 77
آل كاشف الغطاء له غي ما تقدم من الكتب الدلائل في الفقه ورسالة في الأراضي الخراجية، دفن في داره في محلة العمارة وكان الناس يزورون مرقده لقراءة الفاتحة والترحم عليه قبل تهديم دور العلماء وآثارهم ومدارس الحوزات العلمية ومكتباتها القيمة زمن النظام الصدامي البائد.
(69) ماضي النجف وحاضرها : 3/ 225 226.
(70) من كبار علماء حوزة النجف الأشرف في القرن الثالث عشر ومدرسى حوزتها العلمية المعروفين. عرف بالزهد والتواضع وسلامة الباطن حتى عرف بأنه صاحب سر السيد محمد مهدي بحر العلوم (الكرام البررة: 2/ 494) وقد توفي عن عمر ناهز الثمانين عاما ودفن في النجف الأشرف وكان قبره مزارا لذوي الحاجات والطلبات يقصدونه للتبرك والزيارة والسلام حتى أزاله النظام البائد مع ما أزال من المساجد والحسينيات والمدارس العلمية وبيوت المراجع والعلماء.
(71) من المحققين البارعين في علم الأصول. تلقى دروسه العليا في حوزة النجف الأشرف على يد أفاضل أساتذتها المحققين. خص صاحب الكفاية مباحث كتابه الفصول بالمناقشة والنقد وبخاصة ما يتعلق منها بمباحث الألفاظ. سافر إلى أصفهان بعد ذلك. وأكب على الدرس والتحصيل والتدريس فيها أيضا.
(72) أحد أنجال الشيج جعفر آل كاشف الغطاء المتقدم ذكره، وأحد أكابر الفقهاء ومراجع التقليد في النجف الأشرف بعد وفاة والده الشيخ المرجع، ولد سنة (1201 ه / 1787م) وتولى تدريس بحث الخارج في بيته العامر اقام فترة في الحلة الفيحاء ثم هاجر إلى النجف الأشرف فكان مرجعا للتقليد ومصلحا
ص: 78
استطاع بحزمه رد کید نجيب باشا السفاك الذي استباح دماء أهالي كربلاء الطاهرة حتى عدت واقعته بأهل الطف الواقعة الثانية بعد واقعة كربلاء الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) كما استطاع الشيخ المرجع إخماد نار الفتنة بين قبيلتي الشمرت والزكرت التي اشتعلت وأشعلت النجف معها وقد تخرج على يديه جملة من العلماء منهم السيد مهدي القزويني والشيخ الأنصاري والشيخ مشكور الحولاوي. من مؤلفاته الأخرى: رسالة في الإمامة. كتاب في الزكاة وغيرها.
(73) ولد في النجف الأشرف سنة (1201 ه / 1788م) واجتهد في الفروع والأصول مشيدا لما بناه أسلافه من والده والسابقين. وقد امتاز بتعبيره الجميل وبيانه،الحسن، تضلع في الفقه والأصول وهو دون العشرين من سني عمره ما لفت نظر الفقيه السيد جواد صاحب مفتاح الكرامة في إجازته التي منحها إياه حيث قال فيها ولعمر اللّه لإن بقي على هذا الحال من الجد والاشتغال الضربت اليه أعناق الفحول من الرجال. كيف لا وقد بلغ قبل العشرين مبالغ قد تقاصر عنها من بلغ الثمانين (ماضي النجف وحاضرها : 3/ 227).
(74) ماضي النجف وحاضرها. سابق : 3 / 227.
(75) من أكابر فقهاء الشيعة في القرن الثالث عشر. انتهت اليه المرجعية العليا داخل العراق وخارجه وتخرج على يديه العديد من الفقهاء والباحثين وفي مقدمتهم أبناؤه وأهل بيته. له من من الكتب غير ما تقدم : نجاة العباد. هداية الناسكين. رسالة في المواريث.
(76) ماضي النجف وحاضرها. سابق : 3 / 221 وما بعدها.
(77) تاريخ وتطور الفقه والأصول في حوزة النجف الأشرف العلمية. سابق:126
(78)96 جواهر الكلام في ثوبه الجديد. الشيخ خالد الغفوري. مجلة فقه أهل
ص: 79
البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ). العدد 18. السنة الخامسة. دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) قم. إيران. (1421 ه- / 2000م). ص: 183. ومعجم فقه الجواهر وجواهر الكلام في ثوبه الجديد من إصدار دائرة معارف الفقه الإسلامي.
(79) من كبار الفقهاء المجددين في علمي الفقه والأصول ومن المعروفين بالزهد والعبادة، مرجع من كبار مراجع الشيعة في العراق وخارجه في وقته. ومن كبار مجددي علمي الأصول والفقه في القرن الثالث عشر. تتلمذ على يديه العديد من الفقهاء والأصوليين الذين كان لهم دور مشهود في تطوير منهجه العلمي في الفقه والأصول. له من الكتب 29 كتابا أو تزيد، منها من غير ما تقدم إثبات التسامح في أدلة السنن رسالة في الإرث. التقية. الخمس. الزكاة. الصلاة. تقليد الميت. حاشية القوانين الاستصحاب. قاعدة لا ضرر ولا ضرار. مناسك الحج. حاشية نجاة العباد. قاعدة من ملك شيئا. وغيرها.
(80) من مقدمة كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري. بقلم الشيخ محمد علي الأنصاري. من تراث الشيخ الأنصاري. إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم: 1/ 16.
(81) المنهج العلمي لكتاب الأصول العامة للفقه المقارن. سابق: 128- 129
(82) من كبار علماء الحوزة النجفية المحققين وأساتذتها وزعيم الحركة الدستورية في النجف الأشرف والمدافع القوي عن أنصارها في تركيا وإيران برسائله وكتبه إلى السلاطين والحكام من جهة والى العلماء يدعم موقفهم منها من جهة ثانية، عمر مجلس بحثه بمئات الباحثين والطلاب والمجتهدين، وكان حسن البيان قوي الحجة. صلبا شجاعا. مهابا. درس على الشيخ مرتضى
ص: 80
الأنصاري والشيخ راضي. تميزت مدرسته الأصولية بالإيجاز والتهذيب، كان في مقدمة مناهضي دعاة الاستبداد، ومن الداعين بحزم إلى الجهاد ضد الغزاة. عزم على السفر إلى خارج العراق للمشاركة في الجهاد إلا أنه توفي فجأة بمعسكره بأسباب غامضة..
(83) أعيان الشيعة. السيد محسن الأمين: 9 / 5-6.
(84) مقدمة كتاب كفاية الأصول للشيخ الآخوند الخراساني. السيد جواد الشهرستاني : 26.
(85) سليل أسرة معروفة في بلده وهو ابن شيخ الإسلام فيها. من أكابر المحققين في الأصول، والأخلاق والفلسفة والحكمة و من أئمة التقليد والفتيا والمرجعية في النجف الأشرف ومن مشاهير اساتذة بحث الخارج فيها. ومن الجيدين إطلاعا على آداب وشعر شعراء اللغتين العربية والفارسية، إضافة لإجادته الكتابة باللغتين العربية والفارسية. إنشاء وخطا. درس عند الشيخ الآخوند الخراساني زعيم الحركة الدستورية وكان من خاصته وخلص أنصاره.، وساهم في أكثر الحركات الإصلاحية في عصره، تبنى الدعوة، بل التنظير ضد الاستبداد داعما تقييد صلاحية الحكام بشروط محددة ودساتير وقوانين لا يسمح لهم بتجاوزها، وقد أودع نظرياته التنويرية تلك في كتابه القيم: (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) المؤلف سنة (1327 ه / 1909م) وهو كتاب رائد في بابه قياسا بزمن تألفه،وقد حضي باهتمام متزايد بعد تأليفه بعقود من قبل المفكرين المحدثين لسبق تنظيره وعمق مطالبه ومبانيه في طرح مسائل حديثة في الفقه الدستوري من وجهة نظر إسلامية معاصرة، له من الكتب غير ما تقدم: رسالة في المعاني الحرفية. حاشية على العروة الوثقى. حاشية نجاة العباد.
ص: 81
رسالة في التزاحم والترتيب، سؤال وجواب عن الأسئلة التي وردته وأجاب عليها وغيرها
(86) ينظر : ابتكارات الأستاذ الإمام الميرزا النائيني (قدّس سِرُّه) في علم الأصول. د. الشيخ محمد حسين الصغير. بحث ضمن بحوث : مدرسة النجف الأشرف ودورها في إثراء المعارف الإسلامية كلية الفقه 187
(87) تطور البحث الأصولي في مدرسة النجف الأشرف. سابق : 130.
(88) طبقات أعلام الشيعة، نقباء البشر في القرن الرابع عشر. الشيخ أغا بزرك الطهراني. 2/ 594
(89) من أكابر المحققين في الأصول، و من أئمة التقليد والفتيا والمرجعية في النجف الأشرف. درس عند الشيخ الآخوند الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة الأصفهاني وكان زاهدا، له من الكتب: بدائع الأفكار في الأصول. مقالات الأصول. روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي. حاشية موسعة على العروة الوثقى. شرح التبصرة. استصحاب العدم الأزلي. حاشية جواهر الكلام. وغيرها
(90) من أكابر المحققين في الأصول والفلسفة، ومن أساتذة البحث المشهورين ببراعتهم في علوم عدة إضافة إلى الفقه و أصوله كالتاريخ والتفسير والعرفان والأدب. وقد نظم الشعر باللغتين العربية والفارسية درس عند الشيخ الآخوند الخراساني وغيره. له آراء خاصة تتميز بالعمق والجدة والدقة في أصول الفقه والحكمة والعرفان من مؤلفاته: الأنوار القدسية. الحقيقة الشرعية. الطلب والإرادة. نهاية الدراية في شرح الكفاية.
(91) الشيخ محمد رضا المظفر، نقلا عن تطور الدرس الأصولي في مدرسة النجف
ص: 82
الأشرف. سابق: 133.
(92) من مقالات الأصول للمحقق الشيخ ضياء الدين العراقي. بقلم الشيخ محمد مهدي الآصفي: 20/1.
(93) ولد سنة (1247 ه / 1831م) وحضر الأبحاث العالية على يد الشيخ مهدي كاشف الغطاء والشيخ راضي النجفي وغيرهما ثم استقل بالتدريس فتخرج على يدية عدد كبير من علماء الحوزة العلمية ومجتهديها. أفتى بالجهاد ضد التدخل الإيطالي في ليبيا وكذلك ضد الاحتلالين البريطاني لجنوب إيران والروسي لشمالها وله مواقف مشهودة ضد الاحتلال البريطاني للعراق وفي قيادة حركة المقاومة ضد الهجوم الإنكليزي على النجف الأشرف. أسس مدرسة علمية من أهم مدارس النجف الأشرف من حيث السعة وجمال العمارة له كتب عديدة منها غير ما ذكر حاشية على المكاسب الصحيفة الفاطمية رسالة في التعادل والتراجيح وغيرها.
(94) ولد سنة (1284 ه / 1867م) وأكمل دراسته العالية على يد الشيخ حبيب اللّه الرشتي والشيخ محمد كاظم الخراساني وغيرهما من المراجع والعلماء تخرج على يديه المئات من الفقهاء والمحصلين يأتي في مقدمتهم مراجع التقليد: أصحاب السماحة السيد محسن الحكيم والسيد محمد هادي الميلاني والشيخ محمد تقي بهجت والسيد عبد اللّه الشيرازي (قدس اللّه أسرارهم) وغيرهم له من المؤلفات ( وسيلة النجاة) و (حاشية على العروة الوثقى) و (شرح كفاية الأصول) وغيرها
(95) ولد في النجف الأشرف عام 1294 ه / 1877م) تتلمذ على يد الشيخ محمد كاظم الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي والشيخ أغا رضا الهمداني
ص: 83
وغيرهم من فطاحل العلماء وقد انقادت له الخطابة والبلاغة كانقياد العلم والتحقيق فحضر العديد من المؤتمرات الإسلامية في فلسطين ومصر والشام والهند وباكستان أشهرها المؤتمر الإسلامي العربي في القدس سنة(1350 ه/1931م) فقدمه الحاضرون للصلاة إماما في المسجد الأقصى الشريف حيث ألقى خطبته العصماء فيه شارك في الجهاد ضد الإنكليز استجابة لدعوة المجتهد السيد محمد سعيد الحبوبي (قدّس سِرُّه) كما كان له القدح المعلى في المطالبة بحقوق الشيعة المضطهدين في عصره. أسس مدرسة علمية حاول فيها تنظيم الدراسة الدينية كما سيأتي له من الكتب الكثير منها أصل الشيعة و أصولها الآيات البينات التعليق على ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي
(96) من أسرة عرفت في أواسط القرن الثاني عشر الهجري بالعلم فكان أبوه وأخواه وهو من المجتهدين. تضلع بالأصول والفلسفة والعقائد والأدب. أحد أعضاء جماعة العلماء التي تصدت بمباركة المرجع الأعلى السيد محسن الحكيم لمقاومة الانحرافات الفكرية والسياسية في العراق فأبلت بلاء حسنا. من رواد الاصلاح الكبار العاملين في الحوزة العلمية النجفية. أسس مع إخوانه جمعية منتدى النشر وتولى رئاستها. ثم كلية الفقه في النجف وتولى عمادتها. انتخب عضوا في المجمع العلمي العراقي. أديب رائع وشاعر مجيد ولغوي مميز و أصولي وفيلسوف. غزير النتاج. له من المؤلفات غير ما تقدم: السقيفة. محاضرات في الفلسفة. كتاب في تفسير القرآن كتاب في المواريث. مذكراته الشخصية. ديوان شعر.
(97) من أسرة علمية معروفة. يرتفع نسبها إلى السيد إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط (عَلَيهِ السَّلَامُ) ابن الإمام
ص: 84
علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ). توفي والده وهو ابن ست سنوات. جاهد مع المرجع السيد محمد سعيد الحبوبي ضد الإنكليز خلال غزوه للعراق سنة (1332 ه / 1914م) وكان ساعده الأيمن في ساحة المعركة امتدت مرجعيته إلى أنحاء العالم في شرق الأرض وغربها. كان له حضور فعلي في الشأن الاجتماعي السياسي في العراق والعالم الإسلامي. قاوم الأفكار المنحرفة والحكومات الطائفية في العراق بضراوة فاستشهد له من أبنائه وأحفاده وأسرته العشرات. له عدة مؤلفات منها غير ما تقدم حقائق الأصول. نهج الفقاهة. منهاج الصالحين. دليل الناسك.
(98) أدوار الفقه الإسلامي الشيعي. الشيخ محمد إبراهيم الجنّاتي. بحث مجلة الفكر الإسلامي. العدد الثامن من السنة الثانية (1415ه / 1994م): 132 -133.
(99) ولد في النجف عام (1309 ه / 1891م) حضر الأبحاث العالية في الفقه والأصول على يد أكابر المحققين كالشيخ النائيني والشيخ العراقي وغيرهما كما تخرج على يديه العديد من فطاحل العلماء من أمثال المرجع الأعلى اليوم السيد السيستاني والمرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم وغيرهما من العلماء الأعلام الكثير وقد كان المرجع الأعلى في عصره الإمام السيد محسن الحكيم يجله كثيرا ويبجله جاهد مع من جاهد من العلماء ضد الإحتلال البريطاني للعراق ضمن قاطع البصرة وكان محبا للأدب متواضعا من بعض كتبه: رسالة في معاملة اليانصيب الأوضاع اللفظية وأقسامها
(100) من مراجع التقليد في النجف بعد وفاة الإمام الحكيم.ومن المنظرين ورواد الحركة الإسلامية في العراق. ولد في ظل أسرة علمية في الكاظمية ودرس
ص: 85
في مدارس منتدى النشر فيها ثم انتقل إلى النجف ليواصل دراسته الحوزوية فيها. جاهد ضد النظام البعثي الطائفي في العراق وأفتى بتحريم الانتماء اليه فاعتقل أكثر من مرة ثم أستشهد مع أخته الفاضلة بنت الهدى. كتب دستورا لدولة إسلامية وأرسله إلى الإمام بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها. له العديد من المؤلفات غير ما ما تقدم منها فلسفتنا اقتصادنا. البنك اللاربوي في الإسلام الفتاوى الواضحة بحوث حول الولاية. بحوث حول المهدي. فدك في التاريخ.
(101)منهج التاصيل النظري في فكر الإمام الصدر بحث. الأستاذ عبد الجبار الرفاعي. منشور ضمن كتاب: محمد باقر الصدر دراسات في حياته وفكره:144.
(102) امتدت مرجعيته بعد وفاة الإمام الحكيم إلى أنحاء العالم في شرق الأرض وغربها. عكف على البحث والتدريس طيلة عمره الشريف منذ عام (1359 - 1412ه / 1940 - 1992م) فتخرج على يديه المئات من الفقهاء والمجتهدين ومراجع التقليد اللاحقين. له تصدى لترشيد الانتفاضة الشعبانية ضد نظام صدام الظالم سنة (1411ه/ 1991م) فتعرض للاعتقال مع العشرات من العلماء والمحققين في حوزة النجف الأشرف جراء موقفه وموقفهم القوي هذا له عدة مؤلفات منها غير ما تقدم البيان في تفسير القرآن.مباني تكملة منهاج الصالحين. أجود التقريرات. مستحدثات المسائل. تكملة منهاج الصالحين المسائل المنتخبة. تعليقة على العروة الوثقى. وغيرها.
(103) ينظر : تطور الدرس الأصولي في مدرسة النجف الأشرف. سابق : 134.
(104) أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف. الدكتور الشيخ محمد حسين
ص: 86
الصغير : 295.
(105) من مجتهدي الحوزة العلمية في النجف ومن أساتذة البحث الخارج فيها. رفض التصدي للمرجعية رغم محاولات العديدين. منظِّر. ومنهجي واديب وشاعر ورائد من رواد الإصلاح في الحوزة النجفية، وعمد من أعمدة منتدى النشر وعميد لكلية الفقه بعد الشيخ المظفر. رائد انفتاح الحوزة العلمية النجفية على الجامعات الإكاديمية، وأول حوزوي منح درجة (الأستاذية) من جامعة بغداد من دون الوصول اليها عبر دراسة نظامية ليلقي المحاضرات على طلبة الدراسات العليا ويشرف ويناقش أطروحات طلاب الدراسات العالية فيها. انتخب عضوا في المجامع العلمية واللغوية العربية في بغداد ومصر وسورية والأردن. رائد في معالجة الأبحاث اللغوية الأصولية بروح لغوية وأبرز تصدى من الأصوليين للبحث المستقل عن المسائل اللغوية الأصولية. له من المؤلفات غير ما تقدم: القوعد العامة في الفقه المقارن. من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية. مالك الأشتر. شاعر العقيدة. التشيع في ندوات القاهرة
(106) ينظر: المنهج العلمي لكتاب الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم. بقلم. الشيخ محمد مهدي الآصفي:131 149
ص: 87
ص: 88
مرحلتا المقدمات والسطوح
كتبهما الدراسية وطريقة تدريسها
يتضمن هذا الفصل تمهيدا يتناول تعداد مراحل الدراسة في الحوزة وثلاثة مباحث:
المبحث الأول : مرحلة المقدمات وكتبها المعتمدة.
المبحث الثاني: مرحلة السطوح وكتبها المعتمدة.
المبحث الثالث: طريقة التدريس المعتمدة في مرحلتي المقدمات والسطوح.
ص: 89
ص: 90
بات من الواضح أن مراحل الدراسة في الحوزة العلمية النجفية ثلاث هي: مرحلة المقدمات ومرحلة السطوح، ومرحلة البحث الخارج وإن كان هناك من الباحثين من يدمج مرحلة المقدمات بمرحلة السطوح فتكونان معا المرحلة الأولى تتبعها المرحلة الثانية مرحلة البحث الخارج بيد أن التقسيم الأول للمراحل هو السائد.
ولما كانت طريقة تدريس مرحلتي المقدمات والسطوح متشابهة لذا أفردت لهما فصلا واحدا ثم أفردت لمرحلة البحث الخارج المختلفة عنهما في طريقة البحث والنظر فصلا مستقلا لاحقا للفصل الحالي.
أما هذا الفصل الحالي المخصص لمرحلتي المقدمات والسطوح فقد تقاسمته مباحث ثلاثة هي: مرحلة المقدمات وكتبها المعتمدة، ومرحلة السطوح وكتبها المعتمدة، وطريقة التدريس المتبعة في مرحلتي المقدمات والسطوح لأن طريقة تدريس البحث الخارج معروفة وهي طريقة المحاضرة حيث يملي الأستاذ بحثه وينهيه بالإجابة عن الأسئلة إن وجدت.
لذا فسأستهل حديثي عن مراحل الدراسة هذه بالمبحث الأول منها المعنون: مرحلة المقدمات وكتبها المعتمدة.
ص: 91
ص: 92
يدرس الطالب عادة في مرحلة المقدمات العلوم المساعدة لتخصصه الدقيق في علم الفقه مع مقدماته، حيث يدرس طالب الحوزة في مرحلته الأولى هذه علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة، مركزا اهتمامه البالغ على آداب اللغة العربية في هذا الدور من حياته الدراسية باعتبارها لغة القرآن الكريم ولغة السنة الشريفة، بل ولغة المصادر الأصيلة لموضوع تخصصه في الشريعة، بخاصة بعدما باتت تشهده لغتنا العربية الجميلة من ضعف كبير وانحطاط مقلق إلى حدّ بات يخشى عليها من ازدياد تاثیرات العجمة على فصاحتها ناهيك عن ركاكة في الأسلوب وضعف في التعبير وأغلاط لا تعد ولا تحصى في النحو والصرف والاشتقاق عند من يفترض فيهم عكس ذلك فضلا عن غيرهم، ولعل من أسباب تركيز الحوزة العلمية في النجف الأشرف على صون اللغة العربية وآدابها مما دخلها من عجمة أو طغى عليها من لحن علم رجالات الحوزة بأن اللغة العربية لم تلق من الإعراض والإهمال في تاريخها الطويل ما لاقته في القرون المتأخرة قبل عصر النهضة(1). وهذا ما يدعونا إلى الاعتراف بما أسدته مدرسة النجف الأشرف إلى لغة القرآن الكريم من فضل وما بذلته في سبيلها من جهد وبخاصة بعد محاولات التتريك الشرسة التي مارستها الدولة العثمانية ضد اللغة العربية بل ضد الحوزة نفسها.
لذلك كله وغيره فقد ركز منهج الحوزة اهتمامه الكبير على هذا العلم وأعطاه
ص: 93
المساحة الكبيرة من عمر الطالب العلمي في سنيِّه الأولى متدرجا به من دراسة كتاب (الأجرومية) لأبي عبد اللّه بن محمد بن داود الصنهاجي الفاسي المعروف بابن آجروم (ت 143 ه/ 1342م) وهو كتاب أولي في دراسة النحو العربي إلى دراسة كتاب (قطر الندى وبلّ الصدى) لجمال الدين محمد بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت 761 ه / 1360م) وهو أوسع من سابقة وأكثر تفريعا وتنويعا، إلى دراسة كتاب (ألفية ابن مالك) في النحو والصرف لمحمد بن عبد اللّه بن مالك الطائي (ت 672 ه/ 1273 م) وهو أرجوزة نظمت النحو العربي في ألف بيت ليسهل حفظه والرجوع اليه والاستشهاد به متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولألفية ابن مالك أكثر من شرح، منها شرح ابن الناظم، ناظم الألفية لأرجوزة أبيه، ولعل هذا الشرح هو أفضل الشروح، وإن كان أكثرها تعليلا نحويا وتجريدا فكريا، ويحتمل أن يكون هذا هو سبب ميل حوزة النجف الأشرف وأساتذتها إلى تدريسه سابقا قبل أن ينحسر تدریس شرح ابن الناظم وإن ببطء، لصالح تدريس شرح ابن عقيل على الألفية، لكون شرح ابن عقيل شرح أقل تعليلا نحويا من شرح ابن الناظم. ومما ساعد على ميل طلاب حوزة النجف الأشرف إلى شرح ابن عقيل على الألفية صدور وانتشار طبعة محققة منه للباحث النحوي المصري المعاصر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد (ت 1392 ه- / 1972م) حرص محققها على ضبط الأمثلة والشواهد من القرآن الكريم والحديث النبوي والشعر العربي، ثم يشرح الشيخ الأبيات شرحًا وسطا، مع إعرابها كاملة مستعملا عبارة سهلة وأسلوبًا قريبًا، وقد يتوسع أحيانًا في الشرح، ويتعرض للمسائل الخلافية معقبًا أو مرجحًا أو مفسرًا.
ثم بعد انتهاء الطالب من دراسة الألفية وحفظها أو حفظ جلها، نتيجة الدراسة الدؤوبة أو بقصد الحفظ. بعدها يختتم طالب الحوزة دراسته للنحو بدراسة كتاب
ص: 94
(مغني اللبيب) لابن هشام الأنصاري المتقدم ذكره، وربما حرص بعض الطلاب بعد استيعابهم لكتاب (مغني اللبيب) وتأكيدا لرغبته في التوسع أكثر بدراسة النحو والصرف إلى دراسة كتاب (شرح النظام على شافية ابن الحاجب) أو كتاب (شرح الشيخ الرضي على الكافية) وهذا الأخير من أهم كتب النحو المفصلة، وقد أتم الشيخ الرضي كتابة مؤلفه القيّم هذا في النجف الأشرف جوار الحرم العلوي المطهر كما أشار إلى ذلك في آخر كتابه.
أما في علم البلاغة والمعاني والبيان: فيدرس طالب الحوزة في هذه المرحلة كتاب (مختصر المعاني) لمسعود بن عمر بن عبد اللّه التنفتازاني (ت 791 ه/ 1389 م)، ثم يثني بدراسة كتاب (المطول) للتفتازاني أيضا.
وفي علم المنطق سادت دراسة كتاب (المنطق ) للشيخ محمد رضا المظفر (ت 1384 ه/ 1964م)، بل وربما الاكتفاء به من دون الحاجة إلى المزيد بدراسة غيره، وإن كان قسم منهم لا زال يثنّي بدراسة كتاب (حاشية تهذيب المنطق) للملّا عبد اللّه بن شهاب الدين حسين اليزدي (981ه / 1573م ) أو يدرس بعضهم كتاب (تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية) لقطب الدين محمد بن محمد الرازي (ت 766ه/ 1365م)، أو (شرح الشمسية ) لنجم الدين الكاتبى القزويني (ت) 675 ه / 1276م). وقد درج الكثير من الطلاب في عصرنا الحاضر ممن يروم منهم التوسع بدراسة المنطق على ترك دراسة الكتاب الأخير والاكتفاء بدراسة الكتابين المتقدمين عليه كونهم ساعين للتخصص في علم الفقه و أصوله لا في علم المنطق أو علم الكلام أو الفلسفة.
وفي علم الكلام قد يدرس طالب المقدمات كتاب (شرح الباب الحادي عشر) الباب للحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي (ت 726 ه/ 1326م).، والشرح للمقداد بن عبد اللّه بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري
ص: 95
الحلي الأسدي (ت 826ه/ 1423م)، ثم يعقبه بدراسة كتاب (كشف المراد في تجريد الاعتقاد) للعلامة الحلي المتقدم ذكره وقد يؤجل ذلك إلى المرحلة الدراسية اللاحقة.
أما في مقدمات علم الفقه وهو موضوع الاختصاص الدقيق لطالب الحوزة العلمية فيبدأ طالب المقدمات أول ما يبدأ بدراسة رسالة عملية لأحد المراجع العظام من أمثال كتاب (منهاج الصالحين) الذي يتضمن المهم المهم من أحكام فقه العبادات، ثم المهم المهم من أحكام فقه المعاملات.
و كان طالب المقدمات قبلا يبدأ أول ما يبدأ شوطه العلمي في الفقه بدراسة كتاب (المختصر النافع) لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي (ت 676 ه/ 1277 م) الذي لا يتخطى فيه الكاتب المحقق مرحلة استيضاح وفك مغاليق المتون الفقهية ذات العبارات المحبوكة.
ونظرا للدور العلمي/ الدراسي لكتاب المختصر النافع فقد تجاوزت شروحه والتعليقات عليه (55) شرحاً وتعليقاً لأهميته وعمليته.
ثم بعد أن ينهي طالب المقدمات من دراسة (المختصر النافع) في الفقه يثّني بدراسة کتاب (شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام) للمؤلف نفسه، وكتاب (شرائع الإسلام) من أمتن كتب الفقه الإسلامي، وأوسعها انتشارا، وأكثرها شروحا، وأجملها عبارة، وأسبكها نظما، وأجملها منهجة، حيث قسم المؤلف كتابه بمنهجية عالية إلى أربعة أقسام هي: العبادات، والعقود، والإيقاعات، والأحكام، معللا وجه حصره مسائل الفقه بهذه الأقسام الأربعة بقوله : إن المبحوث عنه في الفقه إما أن يتعلق بالأمور الأخروية أو الدنيوية، فإن كان الأول فهو عبادات، وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يفتقر إلى عبارة أو لا، فإن لم يفتقر فهو الأحكام، وإن افتقر فإما من الطرفين أو من طرف
ص: 96
واحد، فإن كان الثاني فهو الإيقاعات كالطلاق،والعتق وإن كان الأول فهو العقود ويدخل فيه المعاملات والنكاح(1).
ثم عكف المحقق الحلي بعد ذلك على كل قسم من هذه الأقسام الواسعة فقسّمه إلى مجموعة كتب أخص فأخص، ثم انثنى فقسم كل كتاب منها إلى أركان، وفصول، وأطراف، وأنظار، وجعل عند اللزوم لبعض الكتب مقدمة أو خاتمة. ثم عاد فقسّم الأركان والفصول والأطراف والأنظار إلى فقرات والفقرات إلى بحوث وهكذا.
أما ما يخص منهجته في عرض الأحكام وترتيبها فقد اعتمد منهج تقديم الواجبات منها، فالمندوبات، فالمكروهات، فالمحرمات، ناصا على ذلك في معرض بيان سبب تأخير حكم مكروه عن غيره من الأحكام الأخرى بقوله : إنما أخرنا هذا الحكم وهو متقدم في الترتيب لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البداءة في كل قسم بالواجب وإتباعه بالندب وتأخر المكروه(2).
ولقد كان حضي كتاب (شرائع الإسلام) منذ أقدم الأزمنة بعناية العلماء وطلاب الدراسات الفقهية فكان موضعا لتدارسهم وشروحهم وتعليقاتهم، ولعل أهم الموسوعات الفقهية التي ألفت منذ عصره حتى عصرنا الحاضر كانت شروحا له(3) عدّ منها محصيها السيد محمد جواد الجلالي (204) شرحا بأسمائها وأسماء مؤلفيها وتواريخ وفياتهم، محددا المطبوع من هذه الشروح وعدد أجزائه، وتاريخ ومكان طبعه، ثم معرّفا بأهم هذه الشروح وهي: (مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام) لزين الدين بن نورالدين علي بن أحمد الجبعي العاملي (ت 966ه/ 1559م)، و (مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام) لمحمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي (ت 1009 ه / 1600م)، و (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) لمحمد حسن ابن الشيخ باقر بن عبد الرحيم النجفي (ت 1266 ه/ 1850م)(4) الذي يعد أكبر
ص: 97
موسوعة فقهية كاملة مطبوعة في الفقه الجعفري كما سيأتي.
بيد أن الحاجة لاستيعاب دورة فقهية عملية معاصرة تحتوي على مستجدات المسائل الحياتية رجّحت لطالب المقدمات البدء بدراسة الرسالة العملية أولا.
أما في علم أصول الفقه : فقد يبدأ الطالب أول ما يبدأ بدراسة شيء ما من كتاب (معالم الدين) أو ما يسميه طلبة الحوزة العلمية بكتاب (المعالم) اختصارا، وهو من تأليف الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (ت 1011 ه / 1602م) أو قد يؤجل ذلك إلى المرحلة اللاحقة تبعا لنصيحة شيخه أو أستاذه، هذا إضافة إلى دروس محبذة أحيانا تستهوي الطالب أو تستهوي أستاذه الموجه له في مسيرته الدراسية، مع قراءات مطلوبة من طالب المقدمات دائما ن أمثال قراءات متأنية في علوم مثل : التفسير والحديث والرجال، والتاريخ والسير، وفنون الأدب العربي وتاريخه، ودواوين الشعر، إضافة القراءة كتب ثقافية عامة ينتقيها الأستاذ لطلابه ويحثهم على مطالعتها والاستفادة منها.
ص: 98
تتركز دراسة الطالب في هذه المرحلة على دروس الاختصاص الدقيق من فقه و أصول فقه وذلك على سطح كتاب مفتوح، وربما سميت لذلك بالسطوح، وربما يدرس الطالب التفسير وعلومه أيضا لشدة احتياجه اليها في شوطه الدراسي القادم.
وأحيانا تتجاوز دراسة الطالب في هذه المرحلة كتب اختصاصه الدقيق إلى غيرها، توسعة لآفاقه النظرية كما كان سائدا في العهود السابقة، فقد كان يدرس طالب السطوح الحساب من خلال كتاب ((الزبدة) للشيخ محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي المعروف بالشيخ البهائي (ت 1030ه/ 1621م)، والهندسة من خلال كتاب (أشكال إقليدوس) كما كان الطالب يراجع في علم اللغة مراجعة دؤوبة كتاب (القاموس المحيط) لمجد الدين الفيروزآبادي (ت)، وكتاب (الصحاح) لأبي نصر إسماعيل الجوهري (ت)، وكتاب (مجمع البحرين) لفخر الدين الطريحي (ت)، وفي علم الرجال يراجع الطالب أو يدرس ما يطلقون عليه في أوساطهم كتاب (رجال أبي علي) محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار (ت)، كما يلم الطالب في هذه المرحلة بكتاب (وسائل الشيعة) لمحمد بن الحسين بن علي بن محمد بن الحسين المعروف بالحر العاملي (ت 1104 ه/ 1693م) الجامع للروايات عن الأئمة الأطهار، وفي تربية النفس وتهذيبها يدرس أو يراجع الطالب كتاب (المفيد والمستفيد) للشهيد العاملي.
أما في موضوع الاختصاص الدقيق وهو الفقه و أصوله، فيدرس الطالب من كتب
ص: 99
الفقه في مرحلة السطوح الكتب التالية: (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) المتن للشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي بن محمد الجزيني العاملي (ت 786ه / 1384م) كتبه في أسبوع جوابا عن رسالة بعثها اليه حاكم خراسان علي بن المؤيد طالبا من الشهيد الأول القدوم إلى خراسان للتصدي للمرجعية، وإذ لم تسمح للشهيد الأول ظروفه بمغادرة الشام كتب اليه (اللمعة الدمشقية) لتكون مرجعا لشيعة خراسان.
وقد ترجم كتاب اللمعة إلى اللغة الفارسية بترجمتين: أولاهما للشيخ محسن غرويان وعلي شيرواني في مجلدين، وثانيهما طبعته جامعة طهران في مجلدين أيضا.
أما شروح اللمعة فقد تعدت سبعة عشر شرحا أشهرها وأكثرها تداولا كتاب (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) للشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي (ت 966ه / 1559م)، وهو شرح كبير ذو عدة أجزاء استوعبت بمجموعها دورة فقهية كاملة ابتداء من كتاب الطهارة وانتهاء بالديات، وقد أربت الشروح والتعليقات على كتاب (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) على (138) شرحا وتعليقا أوسعها وأعمقها مادة وأمتنها استدلالا شرح محمد بن تاج الدين حسين بن محمد المعروف بالفاضل الهندي (ت 1137 ه / 1725م)(1).
لقد حاول الشهيد الثاني بكتابه (الروضة البهية) شرح (اللمعة الدمشقية) تدريب الطالب المبتدئ على أمور مهمة :أولها طريقة الاستدلال والاستنتاج الصحيحين حسب طرائق زمن تأليفه وثانيها: تزويده بالقدرة اللازمة على ممارسة الاستدلال والاستنتاج العلميين. ثالثها: أدب البحث العلمي في المناقشات وطرح الآراء المخالفة باحترام كبير للرأي الآخر.
ثم بعد أن يتم طالب السطوح دراسته لكتاب (الروضة البهية) يواصل دراسته
ص: 100
التخصصية في علم الفقه فيشرع بدراسة كتاب (المكاسب) للشيخ مرتضى بن محمد أمين الدزفولي الأنصاري المعروف بالشيخ الأنصاري (ت 1281 ه/ 1864م) وهو كتاب غاية في الدقة والرصانة قسّمه مؤلفه (قدّس سِرُّه) إلى أقسام ثلاثة هي: المكاسب المحرمة، والبيع، والخيارات، وقد صدّره (رَحمهُ اللّه) بالبحث عن أكثر المكاسب المحرمة في مسائل مستوفيا جهده في الإحاطة بمداركها من أدلتها التفصيلية بدقة متناهية وصدر رحيب في استقصاء الأقوال والأدلة كما هو ديدنه في سائر مؤلفاته، ثم ركز البحث فيه على كتاب البيع وخصوصياته لاشتراكه في أكثر المعاملات في المباني والشرائط العامة وألحقه بالبحث عن الخيارات المعروفة في أبواب المعاملات. وهو مشحون بالتحقيقات الفقهية والمطالب الأصولية(1) وقد طبع طبعات عديدة وشرح شروحا كثيرة أغلبها خلاصة لدروس شراحه من خلال محورية كتاب المكاسب.
وقد يعمد الطالب المجدّ إضافة لدراسته لكتاب المكاسب زيادة في التوسع إلى دراسة كتب فقهية أخرى وهو ما كان يفعله قبل عقود تأتي في مقدمتها كتب من أمثال : المسالك لزين الدين الجبعي والمدارك لمحمد بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي، والتحرير والقواعد للعلامة الحلي، وكتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي.
أما في موضوع التخصص الدقيق الثاني لطالب الحوزة العلمية وهو (علم أصول الفقه) فيبدأ الطالب أول ما يبدأ بدراسة كتاب (معالم الدين) للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني المعروف في أوساط الحوزويين اختصارا باسم (المعالم) المتقدم ذكره، ثم يثِّني بدراسة كتاب (أصول الفقه) للشيخ محمد رضا المظفر بأجزائه الثلاثة، وهو من كتب الأصول الحديثة التأليف، وقد فرض نفسه بعد لأي ككتاب دراسي لا يستغني عن دراسته طالب هذه المرحلة منذ فترة ليست بالبعيدة، ثم طالب السطوح يكمل دراسته الأصولية بدراسة كتاب (فرائد الأصول) المشهور بين الطلبة باسم (الرسائل) للشيخ
ص: 101
الأنصاري مؤلف كتاب (المكاسب) المتقدم ذكره، وهو يتضمن بعمق تحرير مباحث القطع والظن والأصول العملية والتعادل والتراجيح.
وما أن يفرغ طالب السطوح من دراسة كتاب (فرائد الأصول) حتى يشرع بدراسة کتاب (كفاية (الأصول) للشيخ محمد كاظم الهروي الخراساني المعروف بالآخوند الخراساني (ت (1329 ه/ 1911م) وهو كتاب غاية في العمق والدقة والاختصار وضغط التعبير ما يستدعي من دارسه جهدا مضاعفا لاستيعابه ودأبا متواصلا لفك رموزه وحل طلاسمه.
وقد كان المعتاد حتى عهد ليس بالبعيد أن يدرس طالب السطوح كتاب: (المعالم) للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، ثم كتاب قوانين (الأصول) لأبي القاسم الجيلاني، ثم كتاب (الفصول في الأصول) للشيخ محمد حسين الحائري، ثم كتاب (الرسائل) للشيخ مرتضى الأنصاري ثم كتاب (كفاية الأصول) للمحقق الخراساني.
وقد يقدِّم بعض الطلاب دراسة الجزء الأول من كتاب (الكفاية) على كتاب (الرسائل) بإشارة من أستاذه أو ناصحيه.
ويرجع سبب انحسار دراسة كتب (قوانين الأصول) و (الفصول في الأصول) من بين أمور أخرى إلى تعقيد أسلوبها في الأداء وميلها إلى التعبير عن مقاصدها العلمية بأسلوب صعب إضافة إلى احتوائها على مطالب ومباحث قديمة سبق أن تجاوزها علم الأصول فباتت من تراث هذا العلم لا من بحوثه المعاصرة.
ونتيجة الحاجة إلى البيان والتوضيح نشطت كتب الشروح والتعليقات والحواشي على هذه الكتب نشاطا ملحوظا وكثرت كثرة وافرة حتى بلغت شروح بعضها العشرات و شروح بعضها الآخر المئات واختلفت هذه الشروح والحواشي من حيث الإطناب
ص: 102
والإيجاز والبين بين فبلغت شروح كتاب (معالم الأصول) مثلا العشرات، عد منها الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي بأسمائها وأسماء مؤلفيها (35) شرحا، وعد من كتب شروح كتاب قوانين الأصول (35) شرحا كذلك، ومن شروح كتاب الرسائل (99) شرحا، ومن شروح الكفاية (105) شرحا، وهكذا غيرها(1).
أما في الفلسفة الإلهية والحكمة فيدرس الطالب ( شرح المنظومة) للشيخ هادي بن مهدي السبزواري (2) (ت 1289 ه/ 1872 م ) ثم كتاب (الحكمة المتعالية) أو ( الأسفار الأربعة) لمحمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي المعروف بملا صدرا (ت 1050 ه/ 1640م) ذلك الكتاب العميق في فنه الدقيق في مبانيه وطروحاته.
وقد أصبح من المعروف هذه الأيام -لمن أراد التوسع في علمي الكلام والفلسفة - دراسة كتابي : ( بداية الحكمة) ثم (نهاية الحكمة) للسيد محمد حسين بن محمد بن محمد حسين بن علي أصغر الطباطبائي (ت 1402 ه / 1982م) صاحب تفسير القرآن المعروف بتفسير (الميزان) رغم وجود من يسعى من أساتذة حوزة النجف الأشرف الحالية إلى وقف دراسة الكتابين المتقدمين لقناعته بضرر ذلك.
ص: 103
ص: 104
تختلف طريقة التدريس في الحوزة العلمية باختلاف المرحلة الدراسية التي يمر بها الطالب، ففي حين تعتمد مرحلتا المقدمات والسطوح على شرح الأستاذ لعبارة الكتاب المقرر أولاً، حيث يقرأ الأستاذ من كتاب مفتوح بين يديه جملة تامة تنهض بفكرتها العامة لوحدها، ثم يقوم بتفكيكها شارحاً ومفسراً و معلقاً وممثلاً بمثال أو أكثر لتوضيح،مقصده، مستعينا غالبا بصوته في المد والوقف والرفع والخفض، وبلمحات وجهه الموحية وحركات يديه المعبرة لإيصال الفكرة لتلميذه،بجلاء، وربما يعتمد الأستاذ أحيانا كما بتنا نرى مؤخراً على شرح مقطع من مقاطع البحث بإيجاز قبل البدء بتلاوة نص الكتاب، ومن ثم يقوم الأستاذ بقراءة النص المحدد بدرس ذلك اليوم جزءاً جزءاً، وتفكيك عبارة متن الكتاب المقرر فقرة فقرة بتروٍّ وأناة بمعية ما تقدم من شرح أول الدرس، حتى إذا تيقن الأستاذ أن الفكرة قد وصلت إلى تلميذه على الوجه الأكمل، جلية واضحة، بنى عليها فثنَّاها بأختها الرديفة لها موصلا المقطع بالمقطع والفكرة بالفكرة وهكذا.
وقد يعقب الأستاذ شرحه لمتن الكتاب باستعراض المهم من النقود الواردة عليه مما تضج بها حواشي الكتاب المقرر وغيرها مما كتب حول المتن من شروح وتعليقات، ثم يدلي الأستاذ برايه فيها مناقشا ومنتهيا إلى رأي وعادة ما يتم التوسع أثناء تدريس الأستاذ لمرحلة السطوح، وخاصة السطوح العالية منها كما في تدريس كتابي كفاية
ص: 105
الأصول أو المكاسب كما تقدم وقد يزيد الأستاذ المحاضر فيستطرد بتبيين استطرادات موحية يتوسع بها عمَّا هو مقرر في المتن والحواشي لزيادة معارف الطالب وتوسيع أفقه العلمي للفت نظر الطالب إلى أمر علمي خفي لا يتبادر إلى ذهنه عادة إلّا بالإشارة اليه والوقوف بتأنٍ عنده، وبخاصة إذا لمس الأستاذ في طالبه نضجاً وحبا للمعرفة وتشوقاً للاستزادة منها، وهو ما يستحق من أستاذه أن يمده بما هو أوسع من الكتاب المقرر وحواشيه لتنمية قدراته ومهاراته.
وكثيرا ما ينتهي الدرس بإشكالات واستفسارات من الطالب وأجوبة عنها من أستاذه بما قد ترتفع معه سخونة النقاش إلى حدّ ارتفاع وتيرة الصوت لإثبات المطلوب.
يجري هذا كله والطلاب جالسون حول الأستاذ على الأرض أو أمامه يستمعون لدرسه منصتين في حلقة أو غير حلقة قد تكبر أو تصغر نتيجة لأسباب عديدة تدخل فيها المادة الدراسية وشهرة الأستاذ العلمية وحسن بيانه وتوضيحه وسعة صدره لتقبل النقاش والإجابة عن أسئلة طلابه وأمثال ذلك.
فإذا انتهى الأستاذ من درسه وتفرق الطلاب جرت العادة، يتفق اثنان منهم فصاعدا على وقت ومكان محددين لما يطلقون عليه لفظ (المباحثة)، وهي إعادة لشرح درس من الدروس مضت على تدريس الأستاذ له فترة غير بعيدة بما يُضمن معها ابتعاد الطالب عن أجواء ذلك الدرس الخاص ونسيانه لعبارات أستاذه كي يُحرز أن الطالب مستوعب للدرس ومتفهم لمطالبه وليس مرددا لألفاظ مدرسه ترديد غير الهاضم لها، حتى إذا حان وقت المباحثة المتفق عليه بين الزملاء هبّ أحدهم هذه المرة لإلقاء الدرس على زميله أو زملائه متخذا هيئة أستاذه شارحا،درسه مجيباً على إشكالات رفيقه في الدرس أو رفقائه، وهكذا بالتناوب بين الزملاء على الأستاذية يوما، وعلى إعداد الأسئلة التي قد تتطلب منه أو منهم مراجعة كتب وكتب كي يثبت كل منهم أمام زميله
ص: 106
أو زملائه أنه متابع ومستحضر ومجد ومتابع، وهكذا بالتحضير المستمر، والمران على توجيه الأسئلة والإجابة عنها تتطور العملية التعليمية باطراد ودربة.
ومما يزيد من أهمية المباحثة في تثبيت المعلومة في ذهن الطلاب المتباحثين، كثرة الأسئلة والاستفسارات التي يلقيها بعضهم على الطالب الذي اتخذ هيئة الأستاذ في هذه الحلقة، فقد كان يحصل كثيرا أن تمنع هيبة الأستاذ الطالب من توجيه إشكاله على معلومة ما وردت في بحث الأستاذ بينما يستسهل توجيه الإشكال إلى زميله كي يحله له، أما إذا قدر له أن لا يجد ضالته في جواب رفيق بحثه عندئذ لا يجد بدا من أن يتوجه حينها الأستاذه كي يحل له إشكاله العلمي العالق في ذهنه.
ويجب على طالب الحوزة المجد أيضاً أن يكتب كل يوم درسه، ثم يحمله كل مدة إلى أستاذه كي يراجعه ويلاحظه ليتعرف على مستوى فهم تلميذه لدرسه وطريقة تدوينه ل ومدى دقة عبارته في توصيل المبنى العلمي المقصود.
ولو أمعنا النظر في طريقة التدريس في المرحلتين السابقتين من مراحل الدراسة الحوزوية لوجدناها تتردد بين الطريقتين اليونانيتين، طريقة التحليل وطريقة التفسير. أما الأولى فهي أن يتناول الأستاذ الموضوع ويجزئه إلى أقسام، ثم يتناول كل قسم على حدة ويجزئه إلى أجزاء، وهكذا يقسّم ويحلل حتى يصل إلى أدق الأقسام فيتناولها، ويبحث في العلل والعلاقات والمعاني والألفاظ، وقد اشتهر العراق بهذه الدراسة، فكان الأستاذ يكثر في تقدير الموضوع جريا وراء الفروض والاحتمالات على سائر الوجوه، وقد قدم أحد العلماء على مالك في المدينة المنورة وقد كلفه أصحابه أن يسأل مالكا، وكلما أجاب يقول له: فإن كان كذا، وبعد الجواب يكرر : فإن كان كذا، حتى ضاق مالك فقال : هذه سلسلة بنت سلسلة، إن أردتها فعليك بالعراق.
ص: 107
ومن شهرة العراقيين بأسلوب التدقيق في البحث والتحري والاستقصاء والتعمق قول علماء المسلمين منذ القدم: إن الرجل الذي يكثر تقاطيعه بالسؤال والتفريع يُسأل: أعراقي هذا؟. وهذه هي بعض آثار المنطق السرياني واليوناني في العراق.
أما طريقة التفسير والشرح فهي أن يضع الباحث نص القضية فيدرسها ويأخذ بتفسيرها من جميع الوجوه الممكنة ويختار الوجه الذي يستنسبه والتفسير الذي يتذوقه، ويغلب على الأسلوب العلمي النجفي في التحرير والتقرير أسلوب محاورات سقراط المعروفة التي يسمونها اليوم طريقة السؤال والجواب(1) منذ بداية دراسته الحوزوية وحتى نهايتها فعندما يفتح الطالب عينيه لأول مرة على كتاب الأمثلة وهو رسالة صغيرة في الاشتقاق يبتديء به الطالب النجفي حياته الدراسية يواجه هذه الجملة: (إعلم رعاك اللّه) فيدعو الأستاذ الطالبَ أن يسأل نفسه لماذا ابتدأ المصنف الكتاب بقوله : (إعلم) دون أن يقول: (إقرأ)، فيجيب الأستاذ عنه، بعد أن يعجز الطالب عن الإجابة طبعا، بأن الغرض من الدراسة ليس هو القراءة والحفظ بل النظر والفهم.
وهكذا يتدرج الطالب الناشيء منذ أولى خطواته في هذه الحياة الجديدة على النظر والتفكير والمناقشة والنقد(2).
ولا زالت طريقة التدريس هذه متبعة حتى اليوم.
(تنظر طريقة تدريس مرحلتي المقدمات والسطوح في الملحق الثاني)
ص: 108
(1) الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. الشيخ محمد مهدي الأصفي : 17
(2) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. المحقق الحلي: 1/ 18
(3) المصدر السابق : 1 / 19
(4) مقدمة كتاب شرائع الإسلام للطبعة المحققة الأولى. السيد محمد تقي الحكيم: 4
(5) شروح الشرائع. بحث. مجلة فقه أهل البيت. العددان الحادي عشر والثاني عشر من السنة الثالثة. 1999م. ص : 327-356.
(6) شروح اللمعة والروضة البهية. السيد محمد جواد الجلالي. بحث في مجلة فقه أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) العدد العاشر من السنة الثالثة لعام 1998م ص: 175 وما بعدها.
(7) تاريخ وتطور الفقه والأصول في حوزة النجف الأشرف العلمية. سابق : 127.
(8) ينظر: دروس في أصول فقه الإمامية. الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي: 1 / 14-29.
(9) ولد الشيخ هادي بن مهدي السبزواري سنة 1212 ه وتوفي سنة 1289، وكان فیلسوفا بارعا انتهت اليه حكمة الاشراق في عصره كما كان فقيها عارفا، حضر في أول أمره عند الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية في أصفهان وغيره من العلماء والفلاسفة نحوا من ثماني سنوات وأقام في مشهد كما أنشأ مدرسة
ص: 109
في سبزوار أصبحت أكبر معهد للعلوم العقلية من حكمة وفلسفة إلى منطق وغيره في ذلك القرن وقد زاره في غرفته المبنية من اللبن (الطوب) ناصر الدين القاجاري شاه إيران في الأول من شهر صفر سنة 1284ه عند مروره بسبزوار وتناول معه طعام الغداء وكان من الثريد. وكان معروفا بالزهد والورع لا يترك القيام بالثلث الأخير من الليل للتهجد وله المواظبة على السنن وإقامة عزاء الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ). له من الكتب 20 كتابا بين مخطوط ومطبوع كما كان شاعرا باللغتين العربية والفارسية.
(10) الأحلام. الشيخ علي الشرقي : 137
(11) الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. سابق : 24
ص: 110
مرحلة البحث الخارج نظامها وطريقة تدريسها، ومثل تطبيقي عليها
يتضمن هذا الفصل مبحثين
يتناول المبحث الأول منهما مرحلة البحث الخارج من حيث النظام الدراسي وطريقة التدريس.
ويضرب المبحث الثاني منهما مثلان تطبيقيان تقريبيان لطريقة التدريس فيها.
ص: 111
ص: 112
يدرس طالب الحوزة في هذه المرحلة التخصصية العالية، علوم الفقه وأصوله بشكل تفصيلي مركّز، وقد يضم اليهما دراسة آيات الأحكام من كتاب اللّه الكريم دراسة استدلالية معمقة، كما قد يدرس أيضا علم القواعد الفقهية دراسة تفصيلية، وربما يتعمق في دراسة علم الكلام أو علم الفلسفة أو غيرها من الدروس الأخرى التي يرتأي الطالب حاجته اليها كباحث متأن في عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
أما لماذا يركز نظام الحوزة العلمية النجفية على علمي الفقه و أصوله بشكل لافت في هذه المرحلة التخصصية فما ذاك إلّا لأن المحور الأساسي لعملية الاجتهاد والاستنباط وموضوعها في الدين الإسلامي هو علم الأصول والفقه، وهما علمان مستمدان من الكتاب والسنة ومترابطان بترابط متبادل على طول التاريخ، حيث أن علم الأصول قد وضع لممارسة تكوين النظريات العامة وتحديد القواعد المشتركة في الحدود المسموح بها شرعا وفقا لشروطها العامة للتفكير الفقهي التطبيقي، وعلم الفقه قد وضع لممارسة طريقة تطبيق تلك النظريات العامة والقواعد المشتركة على عناصرها الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى، ومن هنا يرتبط علم الفقه بعلم الأصول ارتباطا وثيقا منذ ولادته إلى أن ينمو ويتطور ويتسع تبعا لتطور البحث واتساعه بوجود مشاكل جديدة في الحياة اليومية(1).
ص: 113
وقد سميت هذه المرحلة بمرحلة البحث الخارج، لأن الدراسة لا تتم فيها من خلال کتاب دراسي، حيث يعمد الطالب بنفسه قبل أن يحضر المحاضرة إلى تتبع مادة المحاضرة العلمية المقررة لذلك اليوم من مصادرها سواء أكانت في بحث الفقه أم أصوله وهو الغالب أم التفسير أم القواعد الفقهية أم علم الكلام أم الفلسفة، حريصا على مراجعة أقوال العلماء السابقين ممن يرى أن كتابتهم في هذا المبحث غنية بما فيه الكفاية بحيث تصلح للدليلية على المدّعى ثم يحدد الطالب الأسئلة التي يمكن أن يوجهها لأستاذه في درس اليوم، بعدها يحاول الطالب جاهدا أن يستخلص لنفسه رأياً محددا في موضوع المحاضرة حتى اذا فرغ الطالب من استقراء الآراء وهضمها، حضر إلى مجلس البحث الخارج منضما إلى زملائه الطلبة للاستماع إلى ما سيلقيه الأستاذ عليه ثم يناقش أستاذه بما يرى نفسه أهلا للنقاش فيه.
ومن الجدير بالذكران تلامذة درس الخارج عادة هم والأستاذ سواء، بالنسبة للكتب الدراسية والتي تراجع من حيث لزوم استحضار ما فيها، وإن كانوا ليسوا سواسية من حيث تفهمها واستحضار مضامينها. وربما يوجد في التلاميذ من يستحضر بعضها في ذاكرته أكثر من الأستاذ، ولكن من البعيد وجود من يماثل الأستاذ في تفهمها وتحليلها وإرجاعها إلى أصولها ومبانيها ولو بنحو الموجبة الجزئية(1).
ثم إنه حين تحين ساعة الدرس يدخل الأستاذ المحاضر المجتهد عادة مجلس البحث فيرتقي المنبر المخصص له في حين يجلس تلامذته وحضار درسه تحت منبره ليبدأ محاضرته التي يتناول فيها عادة آراء الفقهاء والأصوليين السابقين في كل مسألة من المسائل العلمية محل البحث التي قد يستغرق استيعابها دروسا بعد دروس ومحاضرات بعد محاضرات لكثرتها وتشعبها، ثم يناقش أستاذ البحث الخارج الآراء المطروحة وأدلتها التفصيلية رأياً رأياً بكل ما تحتاج اليه المناقشة من وقت وجهد، فإذا انتهى من
ص: 114
ذلك كله عرض رأيه المختار مستدلاً عليه بما عنّ له من أدلة وحجج وبراهين داعما حينا ومفندا حينا وطارحا رايا جديدا أحيانا، لتبدأ بعد انتهاء المحاضرة مناقشة الطلاب بما لم يوافقوه عليه من رأي، أو لم يفقهوه من معنى، أو بما لم يستوضحوه من بيان، أو بما لم يذعنوا اليه من برهان.
يقول سماحة الشيخ محمد تقي الفقيه (قدّس سِرُّه) واصفا طريقة تدريس البحث الخارج فترة هجرته إلى النجف الأشرف للدراسة (سنة 1345 ه / 1926م) وما بعدها: إن طلاب البحث الخارج إذا كانوا أقلّاء جلسوا حلقة مستديرة وجلس الأستاذ ناحية قرب جدار أو اسطوانة متجها حيث يشاء، وربما يختار التوجه إلى القبلة تبركا، كما كان يفعل ذلك أستاذنا الحكيم (السيد محسن الحكيم)، ثم يشرع في الدرس، فيسمّي، ثم يحمد اللّه سبحانه وتعالى ويصلي على النبي وآله، ثم يذكر موضوع البحث، ويبين آراء العلماء وأقوالهم فيه وربما يذكر مصادرها، ثم يبيّن مقتضى الأصل والقاعدة فيها، ثم يشرع في سرد أدلة الأقوال واحدا واحدا فيسددها ويشيدها ويقرّبها من الأذهان، ثم يكرّ ويبيّن ما تضمنته من الخلل إن كان لا يرتضيها، وينتهي باختيار أحد المذاهب الذي تكون البراهين عليه سالمة من الشك. وإذا بلغ الطلاب عددا يتعذر معه إسماعهم مع الاستدارة، جلسوا مجتمعين غير مرتّبين والتمسوا من الأستاذ أن يرقى على المنبر مرقاة أو مرقاتين حسب الحاجة فيجيبهم، ثم إذا انتهى من بعض مقدمات الدرس أو جهاته التي تناولها في حديثه تقدّم الطلاب بالتعليق على ما أفاده، وربما تصدّى بعضهم بإقناع بعض، وكثير ما يستحكي الطالب من هو على يمينه أو يساره مستفسرا أو مناقشا بشكل هاديء لا يشوش الجو على الآخرين، وكثيرا ما لا تنفصل الخصومة بين التلاميذ أنفسهم، فتشرئب الأعناق إلى الأستاذ بطبعها، وقد يسكتهم هو بنفسه، ثم يستطرد الشبهات التي ذكروها واحدة واحدة، ويبين منشأها ويسدّدها أحيانا حتى يخيّل لمن
ص: 115
لا يعرف العادة أنه يقول بها ويختارها، ثم يأتي على تلك المباني فيجعلها هباء منثورا(1).
ولا زالت هذه الطريقة نفسها متبعة حتى اليوم (تنظر طريقة تدريس البحث الخارج في الملحق الثالث).
حتى اذا تم ذلك كله وانتهى الدرس وانتهت بعده مناقشته عاد كل طالب منهم إلى بيته ليكتب مبحث أستاذه الذي استوعبه بالمحاضرة وحدها حينا، أو بها وبرديفتها المناقشة حينا آخر. أو بهما وبالمراجعة اللاحقة لأفكارها أو بمعونة زميل نابه من زملاء بحثه لها أحيانا.
وقد جرت العادة أن يعرض الطالب المجدّ كتابته على أستاذ درسه كي يطمئن الطالب من سلامة بيانه لمطالب أستاذه من ناحية، ويتأكد الأستاذ من دقة تعبير تلميذه عن آرائه التي تلقاها منه وحسن بيانه لما تعرض له من ناحية ثانية.
فإذا أتمّ الطالب تدوين آراء مدرسه واستحسن الأستاذ كتابة تلميذه مادة وأسلوباً ودقة تعبير عن المقصود وإحاطة بالفكرة وسلامة بيان لدقائقها، ثم أراد طالبه طباعة ما كتبه من آراء أستاذه قصد أستاذه راجيا منه أن يكتب لما قرره من مباني شيخه مقدمة يصدِّر بها كتابته للتقريرات تصرح للقارئ بأن هذه الآراء تمثل آراء أستاذه تمثيلا دقيقا، بحيث يقرّ صاحب الرأي بصحة نسبة تلك الآراء اليه وإن كانت بقلم الطالب المشتغل، وتسمى تلك الكتابة بالتقريرات وحين تطبع يكتب على غلاف المطبوع حينئذ بما يشبه الجملة التالية : (تقريرات بحث الأستاذ، إنما بقلم تلميذه كاتب التقريرات) وهكذا.
فالتقريرات إذاً هي عنوان عام لبعض الكتب المؤلفة منذ أواخر القرن الثاني عشر وبعده حتى اليوم، وهو نظير (الأمالي) في كتب الحديث للقدماء. والفرق أن الأمالي كانت تكتب في مجلس إملاء الشيخ أو روايته للحديث عن كتاب يحمله معه أو عن
ص: 116
ظهر قلبه، وكان السامع يكتب الكتاب باسم الشيخ الذي أملى الأحاديث، ويعد من تصانيف الشيخ، بخلاف (التقريرات) فانها مباحث علمية يلقيها الأستاذ على تلاميذه عن ظهر قلب ويعيها التلاميذ في حفظهم، ثم ينقلونها إلى الكتابة في مجلس آخر، ويعد من تصانيفهم هم.(1) إنما تحتوي على آراء الأستاذ ومبانيه، فصاحب الكتابة هو الطالب الذي استمع وفهم ووعى ما سمع ثم دوّن ما استوعب، وصاحب الرأي والمبنى هو الأستاذ المحاضر.
والذي يحسن تبيانه هنا هو أن كتب التقريرات هذه أكثر من أن يستقصيها أحد، ولاسيما التقريرات الأصولية حيث عدّ منها سماحة الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي الكثير الكثير(2).
إن كتابة التقريرات التي تحتوي عادة على مباحث غاية في الدقة العلمية تحتاج إلى كاتب يحسن التعبير عنها ويبرزها للقاريء أو الباحث كما لو كان سمعها من الأستاذ نفسه بحيث يرى الأستاذ المجتهد أنها حاملة لمبانيه العلمية ومطالبه وموضحة لأفكاره وتحليلاته فيرتضيها معبرة عما انتهى اليه رأيه في المسائل محل البحث، لا يقوى عليها عادة إلاّ الطالب المشتغل المجد المتميز بين أقرانه المشار اليه بالبنان في محيطه وحوزته حتى ليأمل منه أستاذه وأقرانه الطلاب والحوزة العلمية بشكل عام أن يحتل موقعا صاعدا في الحوزة العلمية مستقبلا.
ويرى بعض الباحثين أن طريقة تدريس البحث الخارج ليست بقديمة قدم المرحلتين السابقتين: مرحلة المقدمات ومرحلة السطوح، ويذهبون إلى أن سماحة الشيخ محمد بن شريف بن حسن علي المعروف بشريف العلماء المازندراني الآملي المتوفى سنة (1245ه / 1829م) المتقدم ذكره هو أول عالم شيعي بدأ تدريس بحوث الخارج، ولم يكن ذلك معروفا قبله والسبب في ذلك يعود إلى الشيخ الأنصاري صاحب كتاب
ص: 117
المكاسب وسعيد العلماء البابلي فقد كان هذان العالمان يشتركان في مباحثة واحدة فيما بينهما، ولما كانا من أبرز طلبة شريف العلماء فقد كانا يكثران من طرح الأسئلة، فكان يضطر في الإجابة على أسئلتهما وإشكالاتهما إلى ترك الكتاب، فما زال هذا الأمر يتكرر حتى ترك شريف العلماء كتاب المعالم الذي كان يدرسه لتلاميذه، وأخذ يلقي دروسه دون کتاب. ومنذ ذلك الحين أخذ العلماء يلقون دروسهم في الخارج دون كتاب(1). حتى إذا أتمّ الأستاذ المجتهد دورته الفقهية أو الأصولية شرع بتدريس دورة أخرى جديدة بحضور طلاب جدد وهكذا حسب تشخيصه للحاجة وتبعا لظروف النجف وظروفه الخاصة وفي مقدمتها الصحية منها ومع ذلك فقد وجدنا من المراجع من درّس دورة كاملة أو دورات كما وجدنا من استمر عشرات السنين يدرس البحث الخارج دورة بعد دورة كما هو حال المرجع الأعلى في وقته سماحة السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) الذي استقلّ بالبحث الخارج العالي طيلة ستين عاما متواصلة وقد وهبه اللّه عمرا مديدا ما فرّط بيوم واحد منه، حتى ما رآه أحد إلّا مدرسا أو دارسا أو مطالعا أو محررا أو مفكر(2).
ويذهب الباحثون في تاريخ نشوء مصطلح (البحث الخارج) أيضا إلى أن إطلاقه على المرحلة الثالثة العالية من مراحل الدراسة الحوزوية قد بدأ في فترة شريف العلماء المتوفى (سنة 1245ه/ 1829م)(3).
وتخضع سعة حلقات الدرس في البحث الخارج وضيقها لشهرة الأستاذ العلمية وقوة حجته ومتانة دليله وعمق مطالبه و وضوح بیانه و مدى نجاحه في توصيل مادة البحث العلمية وأمثال ذلك، فقد كان مثلا أستاذ البحث الخارج في الأصول المرجع الشيخ محمد كاظم الخراساني المتوفى (عام 1329 ه/ 1911م) يحاضر في مسجد الهندي في النجف الأشرف وكان كما وصف الشيخ علي الشرقي يحف بمنبره ثلاثة آلاف طالب فيهم المجتهد أو المرشح للاجتهاد وكانت له الروعة والهيبة إذا استوى فوق منبره وإذا
ص: 118
انتهت محاضراته وانتشر تلامذته تقف حركة المرور، فلا ترى غير تموّج العمائم البيض والسود(1). هذا أحيانا وأحيانا يقل العدد عن ذلك حسب الظروف الزمانية والمكانية وغيرها. فقد قال الشيخ أغا بزرك الطهراني : سمعت ممن أحصى تلاميذ الأستاذ الأعظم المولى محمد كاظم الخراساني في الدورة الأخيرة في بعض الليالي بعد الفراغ من الدرس أنه زادت عدتهم على (2200 ) ألفين ومائتين وكان كثير منهم يكتب تقريراته(2).
ونقل عن المرجع الشيخ أغا ضياء العراقي أن عددهم تعدى (1700) ألفا وسبعمائة نفر في الليلة. وعن السيد هبة الدين الشهرستاني قوله: عددنا حضار درس الشيخ فكان في إحدى الليالي ( 1540) ألفا وخمسمائة وأربعين شخصا(3).
وليس في ذلك تضارب في الأقوال كما ذهب إلى ذلك بعضهم(4)، فقد جرت العادة أن يزداد أو يقل حضور طلبة البحث الخارج من بحث إلى بحث، ومن يوم إلى يوم حسب الظروف والأحوال، وهو ما بدا واضحا في أقوال المحصين أو العادين، فرواية الشيخ أغا بزرك الطهراني تتحدث عن طلاب (بعض الليالي في الدورة الأخيرة) للشيخ، وهي لا تعارض رواية الشيخ الشرقي التي قد تتحدث عن ليال في دورة أو دورات أخرى، وكذلك لا تعارض رواية الشيخ الشرقي أيضا ما نقل عن المرجع الشيخ العراقي (قدّس سِرُّه) التي نصت إضافة لما تقدم على أن عددهم (تعدى) الرقم المذكور فيها، وهي لا تعارضها أيضا رواية السيد الشهرستاني فهي إضافة لما تقدم نصت على عدد الطلاب في (إحدى الليالي) لا عددهم الكلي في ليالي البحث عادة.
وأياً كان العدد الحقيقي لعدد طلاب بحثه (قدّس سِرُّه) الذي قدرته أقل هذه الروايات ب(1540 ) طالبا، وأكثرها ب(3000) فهو عدد كبير جدا، خاصة إذا عرفنا أن هناك من قدر عدد المجتهدين حينها ب أكثر من ألف مجتهد في علمي الفقه والأصول(5).
ص: 119
وليس هذا العدد الكبير لطلاب البحث الخارج أو ما قاربه مما اختص به المرجع الشيخ الخراساني (قدّس سِرُّه) وحده - وإن كان (قدّس سِرُّه) في مقدمة من حظيت دروسهم بهذا العدد الغفير من الطلاب لأسباب منها عمق مادته العلمية، وحسن بيانه، وكثرة الطلاب تلك الآونة - فقد اعتدنا أن نسمع أو نقرأ عن حضور عدد مقارب لطلاب الشيخ الخراساني متى ما اشتهر اسم أستاذ لبحث من بحوث الخارج بارع في مادته وطريقة عرضه، ومتى ما تركت الحوزة العلمية وشأنها تنمو تدريجيا من دون مضايقات أمنية أو طائفية أو حدودية أو طارئة كالحروب والتسفير الإجباري التعسفي والتجنيد الإجباري ومنع دخول الطلاب للدراسة وأمثالها، حينها تنمو الحوزة العلمية شيئا فشيئا حتى يصل أعداد طلاب المرحلة الدراسية العليا منها إلى المئات وقد يتعدى ذلك.
فقد حدثتنا كتب التاريخ مثلاً أن المرجع الشيخ موسى آل كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه) المتوفى (سنة 1241ه/ 1826م) حضر مجلس درسه في أواخر أمره من طلبة العجم ألف رجل هاجروا من كربلاء بعد وفاة شريف العلماء(1) هذا عدا ما سواهم من الطلاب العرب وغيرهم من حملة الجنسيات الأخرى.
كما حدثتنا كتب التاريخ أيضا أن المرجع الشيخ علي ابن الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه) المتوفى (سنة 1253 ه/ 1837م)(2) كان يحضر درسه ما يزيد على الألف من فضلاء العرب والعجم(3) وهناك غيرهما من الأساتذة ممن بلغ حضار درسه المئات.
بيد ان هذا العدد الضخم من طلاب الحوزة العلمية النجفية قد بدأ بالانحسار تدريجيا نتيجة الضغوط الأمنية والمضايقات القاتلة على حوزة النجف الأشرف ومرجعياتها وطلابها المتقدم ذكر بعضها، ومنها عدم منح أو تجديد الإقامات للطلبة الوافدين من غير العراق للدراسة العلمية فيها.
ص: 120
ولا زلت أذكر خلال أواسط عقد الستينات الميلادية من القرن الماضي ما كنت أشاهده في المسجد الذي اعتاد أن يلقي فيه المرجع الأعلى في عصره سماحة الإمام السيد محسن الحكيم المتوفى (سنة 1390ه/ 1970م) حيث كانت باحته تغص بالطلاب المنصتين أثناء إلقاء سماحته لبحثه وأذكر أيضا مثل ذلك الحضور في درس المرجع الأعلى في عصره سماحة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي المتوفى (سنة 1412ه/ 1992م)، حيث قدر عدد حضار بحثه الخارج بما يتراوح ما بين (400 500) أربعمائة - خمسمائة طالب، يكتب (95%) خمسة وتسعين منهم البحث، وهو مؤشر على كثرة الطلبة المشتغلين بينهم.(1)
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد انخفضت أعداد الطلاب بشدة بعد الحرب الدموية المعلنة والمخفية التي شنها الحكام الظالمون على حوزة النجف الأشرف وعلى مرجعيتها العلمية الدينية ككيان ومراجعها وأساتذتها وطلابها كاشخاص منتمين لذلك الكيان العلمي العريق، وخاصة خلال فترة حكم النظام العراقي البائد منذ (سنة 1388ه/ 1968م) وحتى سقوطه المدوي عام (1424ه/ 2003م خشية منهم على حياتهم من ملاحقة وصلت حدّ الإعدام والسجن والتهجير القسري وغيرها خاصة بعد علم هؤلاء الطلاب علم اليقين أن الأنظمة الظالمة قد أعدمت وسجنت الكثير الكثير منهم.
ثم كان أن عادت الحوزة العلمية وتنفست الصعداء بعد زوال النظام الصدامي فبدأت أعداد طلابها وحضار دروسها على مختلف مراحلها بالازدياد تدريجيا، وبديهي أن طلاب البحث الخارج أقلهم عددا الحداثة حرية الانتماء إلى الحوزة بعد سقوط صدام، حيث أن الوصول إلى هذه المرحلة العليا يحتاج إلى أن ينهي الطالب مرحلتي المقدمات والسطوح السابقتين عليها وهو ما يحتاج من الطالب إلى زمن ليس بالقليل، فالقضية
ص: 121
نسبية ومتفاوتة بين هذا الأستاذ وذاك، وبين هذا الظرف وذاك، وبين هذا الموضوع وذاك كما أسلفت.
وقد حضرت بحثا من بحوث الخارج في الفقه للمرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دَامَ ظِلُّه) في مكتبه العامر في النجف الأشرف صباح يوم دراسي من أيام شهر رجب قبيل حلول العطلة الصيفية (سنة 1427ه/ 2006م) بأسبوع، حيث كان سماحته يباحث في (الخيارات) من كتاب البيع في فقه المعاملات، وقد تجاوز حضار الدرس ثلاثين طالبا، كان بعضهم يكتب الدرس، وبعضهم وهم الأكثر يكتب ملاحظات عنه، بينما جلب بعضهم الآخر مسجله معه واضعاً إياه جنب لاقطة الصوت ليسجل كل كلمة أو حرف ينطقه الأستاذ رغبة من التلميذ الباحث في إعادة سماعه ثانية قبل كتابة الدرس ضمانا لدقة نقل رأي الأستاذ ونسبته اليه وهكذا شيئا فشيئا تبدأ دروس بحث الخارج في الحوزة العلمية النجفية نموها التدريجي شيئا فشيئا إن شاء اللّه تعالى.
كما تشرفت بعد ذلك بحضور درس فقهي آخر للسيد المرجع نفسه صبيحة (يوم الأربعاء 15 ربيع الأول سنة 1428ه الموافق ليوم 2007/4/4م) وكان موضوع البحث هو (ضمان قيمة يوم التلف) حيث عرض الأقوال المختلفة في المسألة مركزا على رأبي المرجعين الراحلين السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدس اللّه سرهما) وذهب إلى تبني رأي جديد مخالف لهما في المسألة.
وقد لاحظت - بعد تكرار حضوري للبحث في فترات أخرى متقطعة لغرض الملاحظة - الزيادة الكبيرة في عدد طلاب البحث الخارج هذه المرة قياسا بالمرة السابقة بما أربى على الضعف حيث بلغ عددهم بعد أن أحصيتهم (70) سبعين طالبا، يزدادون مرة عن مرة حضورا ومناقشة، وخاصة في هذه السنة (1432 ه/ 2011م) وبعدها.
ص: 122
لئن كانت طريقة تدريس مرحلتي المقدمات والسطوح المتقدمة لا تحتاج إلى مثل تطبيقي عليها، فإن طريقة تدريس مرحلة البحث الخارج ربما تحتاجه، ومن أجل تجلية طريقة تدريسها بات من الحسن أن أستشهد بمثلين تطبيقيين لدرسين من دروسها يقربان القاريء إلى حد مقبول من طريقة تدريس البحث الخارج، أولهما للمرجع الشيخ محمد كاظم الخراساني الملقب بالآخوند المتوفى فجر يوم الثلاثاء 20 من شهر ذي الحجة سنة(1329ه/ 1911م)، صاحب كتاب (كفاية الأصول) في علم الأصول، وثانيهما للمرجع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء المتوفى فجر يوم الاثنين 18 من شهر ذي القعدة سنة (1373 ه/ 1954م)، صاحب كتاب (تحرير المجلة) في الفقه المقارن.
أما الأول فقد ورد أن شهرة الشيخ العلمية وعمق مباحثه في بحث الخارج قد اشتهرت في البلاد حتى حضر لديه في تلك السنين حاكم النجف من آل الآلوسي فعرض لحضرته أن بعض الأفاضل المؤلفين كتب اليه من الإستانة كتابا يقول فيه: بلغني أن عالما خراسانيا ظهر في النجف وجدد معالم فن الأصول وأنه في هذا العصر كالعضدي في زمانه فارسل ترجمته وأحواله بقدر ما تستطيع(1) كما تخطت شهرته حدود العراق حتى وصل خبر ذلك إلى جميع أرجاء الدولة العثمانية، فاشتاق علماء تلك
ص: 123
الديار للحضور في مجلس درس هذا العالم العيلم حتى قام شيخ الإسلام بنفسه لرؤية الشيخ الآخوند والارتشاف من نمير علمه بحجة أنه يروم السفر إلى قبر أبي حنيفة في بغداد ومن ثم عرج من بغداد إلى النجف ليشاهد الحوزة التي مضى عليها حوالي الألف عام، وكان الشيخ الآخوند يدرس في مسجد الطوسي ودخل شيخ الإسلام بدون سابق إنذار، وبمجرد دخوله حدثت همهمة بين الطلاب وفسحوا له المجال ليجلس في المكان المناسب له بالقرب من المنبر.
وهنا برعت براعة الآخوند،وفراسته، فإنه بمجرد أن رأى شيخ الإسلام وقد عرفه من ملابسه ومن هيئة المحيطين به فنقل البحث إلى قول أبي حنيفة بأن (النهي في الوجوب والحرمة دليل الصحة لا الفساد) وشرع في بيان هذا الدليل وما يؤيده على أحسن ما يرام وببيان جذاب فاندهش شيخ الإسلام من تسلّط الآخوند على مباني أبي حنيفة وغيره من أئمة السنة، وغرق في بحر التأملات، وكيف أن هذا العلم قد وصل في النجف إلى ما وصل؟.
ثم انبرى الآخوند يذكر الإشكالات الواحد تلو الآخر على قول أبي حنيفة المذكور، فما كان من شيخ الإسلام إلا التصديق والإذعان لما يقوله الآخوند.
واستمر الآخوند في ذكر أقوال العلماء حتى وصل إلى الرأي الفصل وهو رأي أستاذه الأكبر الشيخ الأنصاري بأن (النهي في الوجوب والحرمة دليل على فساد ذاك الحكم).
وعندما وصل في بحثه إلى هذا الحد قال : الظاهر ان القادم هو شيخ الإسلام العثماني واحتراما لمقدمه أنزل عن المنبر ليفيض علينا من بعض علومه.
ولكن شيخ الإسلام الذي بهرته معلومات الشيخ الآخوند ولكثرة حضار مجلس
ص: 124
الدرس الذين تجاوز عددهم الألف أبى أن يصعد المنبر وآثر الجلوس مع الشيخ برهة من الزمن. ويقال إن جل حديثه في سفره عند رجوعه إلى بلده كان يدور حول شخصية الآخوند العلمية (1).
ويمكن من خلال هذا العرض لحضور شيخ الإسلام درسا من دروس البحث الخارج في حوزة النجف العلمية معرفة اهتمام أستاذ البحث الخارج في عرض الآراء المختلفة في المبحث المطروح حتى أنه طرح رأي أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي المتوفى سنة فيه، رغم البعد الزمني الكبير بين الشيخ الخراساني وأبي حنيفة الذي تجاوز الألف عام، والأهم من ذلك يمكن ملاحظة نزاهة وموضوعية أستاذ البحث الخارج في تناول الرأي الآخر بحيث أنه (قدّس سِرُّه) حين عرض الرأي المخالف لرأيه، عرضه بما أقنع المستمعين بسلامته ودقته كما لو كان هو رأيه المختار، ثم ناقشه بعد ذلك فأقنع مستمعيه ببطلانه. كما يمكن استيضاح مدى دقة أستاذ البحث الخارج في مناقشة الآراء العلمية وصولا إلى الرأي المختار.
وأما المثال الثاني لدرس من دروس البحث الخارج فقد أعد بارتجال من دون سابقة عهد او تهيئة أو إعداد.
فقد زار وفد علمي مصري يرأسه الباحث أحمد أمين صاحب كتب: «فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام» مدينة النجف الأشرف ليلة 21 من شهر رمضان المبارك من عام (1349ه / 1930م) على رأس وفد مصري كبير مؤلف من زهاء ثلاثين بين مدرس وتلميذ، واجتمع بالمرجع الديني في وقته سماحة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه) في داره العامرة ومشاهدة مكتبته القيمة، ومكث ومكثوا هزيعا في ليلة من ليالي شهر رمضان حيث مجلس الشيخ غاص بمحفل علمي حاشد فدارت بين رئيس الوفد المصري أحمد أمين والشيخ كاشف الغطاء أحاديث شتى بدأها الشيخ
ص: 125
فعاتبه عتاباً خفيفاً عما أورده في كتاباته غير الأمينة عن الشيعة ثم استمر الحوار العلمي بينهما بما استطاع تدوينه ساعتها الشاعر الشيخ صالح الجعفري الذي كان حاضرا تلك الجلسة، لتنشرها له بعد ذلك مجلة (العرفان) اللبنانية الواسعة الانتشار في الصفحة: 308 وما بعدها من الجزء الثالث من المجلد (21) لسنة (1349 ه/ 1930م)(1)
وخلاصة الأمر أن الأستاذ أحمد أمين طلب يومها باسم البعثة العلمية المصرية التي كان يراسها في زيارتها تلك للنجف الأشرف من سماحة الشيخ المرجع في تلك الجلسة أن يستمع لبحث يلقيه في موضوع يختاره ليتعرف الوفد على طريقة تدريس البحث الخارج في حوزة النجف العلمية، فما كان من الشيخ إلا أن صعد المنبر بعد أن اجتمع حوله من حضر الجلسة من تلاميذه وضيوفه وبدأ على غير سابقة عهد ولا تهيئة مرتجلا بعد البسملة البحث التالي مبتدأ بقوله تعالى: «وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ».
وها أنذا أثبتُهُ كما ورد، وأضيف أن دروس البحث الخارج غير المرتجلة كهذا الدرس أكثر تفصيلاً، وأعمق تحليلاً، وأشمل استعراضاً وأدق نقدا وتقييما للمباني والمطالب في الغالب مما تحدث به المرجع الشيخ كاشف الغطاء في درسه الارتجالي الذي أحسن فيه وأجاد، وذلك لتناول بحوث الخارج عادة ذكر الآراء المختلفة في المسألة محل البحث بعد نسبتها إلى أصحابها القائلين بها، مع استعراض أدلتهم عليها ومؤيداتهم لها، مناقشة تلك الأدلة ببيان نقاط القوة والضعف فيها وما إلى ذلك من خصوصياتها ودقائقها، وصولا إلى الرأي المختار في المسألة، وهكذا في المسائل اللاحقة لها بالتتابع.
أعود فأقول: لقد بدأ المرجع الشيخ آل كاشف الغطاء حديثه بالبسملة كما أسلفت ثم أضاف بعدها مبتدئاً بحثه بالاستشهاد بالآية القرانية الكريمة كي تكون محور درسه غير المعّد والمهيأ له سلفا :
ص: 126
قال تعالى: «وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»(1)
تشتمل هذه الآية على عقدين : عقد سلب وعقد إيجاب.
أما عقد السلب : «وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ». فهو من الأساليب القرآنية التي اخترعها وارتجلها في الاستعمالات العربية، ولم تكن معروفة من ذي قبل، وقد تكررت هذه الجملة في القرآن الكريم.
وهي تارة تتعلق بالأفعال مثل قوله تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن»(2). وقوله تعالى: «لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى»(3)، ويكون المراد حينئذ على سبيل الاستعارة بالكناية المبالغة في التحذير عن ارتكاب ذلك الفعل كالزنا والصلاة مع السكر أو غير ذلك. وشبّه اسم المعنى باسم العين فحذّر من قربه، فكيف بملاصقته أو الدخول فيه.
وأخرى تتعلق بالأعيان مثل قوله تعالى: «وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ»(4)، وقوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»(5).
ومن هذا القبيل آية العنوان التي هي من براعة الصنعة وإبداع البيان بمكان، وحيث أن النهي لا يتعلق بالأعيان رأساً، بل لا بدّ من توسط فعل مقدّر في البين يناسب تلك العين، فإذا قيل: حرمت أمهاتكم عليكم، يعني العقد عليهن. وإذا قيل: حرّمت الخمر، يعني شربها. وإذا قيل : حرم الميسر والقمار، يعني اللعب بهما، وهكذا يقدر في كل مناسب ما يناسبه، بل أظهر ما تتعلق به الأفعال التي تطلب من تلك العين ومما هي معدّة له، فلا يراد من قول حرّمت الخمر، حرمة كل الأفعال التي يمكن أن تتعلق بها فيحرم لمسها أو النظر اليها أو التداوي بها وهكذا. كلا، بل ليس المراد إلّا حرمة شربها. وعليه فيكون المراد والمعنى بالآية التي في العنوان: لا تتصرفوا في مال اليتيم التصرفات
ص: 127
المطلوبة عند العقلاء من المال بالاتجار به في بيع أو شراء أو صلح أو رهن أو إدانة أو غير ذلك.
والغرض أيضا بهذا النحو من البيان: شدة التحذير والنهي عن التصرف في مال اليتيم بحيث يكون المعنى والمقصود النهي عن المعاملة بمال اليتيم بوجه مطلق من رفع أو وضع أو فعل أو ترك إلّا بالتي هي أحسن، أما حيث لا تريدون التصرف فلا شيءعليكم.
وإن كان التصرف أحسن بخلافه على الوجه الثاني، فإن مفاده لزوم التصرف بالأحسن يؤيد الحكم الضروري من حرمة التصرف بمال الغير مطلقا صغيرا أو كبيرا بغير إذنه، وليس المقصود أصالة البيان بالضرورة، وإنما المقصود عقد الإيجاب وهو إعطاء الرخصة بالتصرف في مال اليتيم إذا كان في التصرف مصلحة فيكون مخصصا لما دل على عموم حرمة التصرف في مال الغير.
إنما الكلام في مقدار تلك الرخصة وحدودها حسبما يستفاد من الآية، فإن محور البحث والنظر يدور من هذه الجهة على تشخيص المراد من لفظ (الأحسن)، وهل هو من أفعل التفضيل نظير: الصلاة خير من النوم. وعلى الأول، فهل المراد من (الأحسن) بقول مطلق، أي ما لا أحسن منه. وعلى الثاني، فهل المراد منه ما اشتمل على مصلحة، أو يكفي خلوّه من المفسدة بناء على أن كل ما ليس بحرام فهو حسن.
ثم لما انتهى إلى هذا المقام طلب بعض الحضور تغيير الموضوع، ونقل البحث إلى مسألة من المسائل الاعتقادية وأساسيات أصول الدين، فأوصل سماحته الكلام اقتضابا من غير روية ولا تمهل، ونقل البحث إلى مسألة الحاجة إلى الأنبياء وضرورة البعثة فقال:
إن النظر في عامة أحوال البشر يعطي أن أعرف صفاته وألصقها فيه وأقدمها عهدا
ص: 128
به هي الخلال الثلاث التي لا يجد عنه محيصا ولا منها مناصا مهما كان ألا وهي الجهل والعجز والحاجة، وهذه الصفات هي منبع شقائه وأصل بلائه، وكلما توغل الإنسان في العلم والمعرفة تطامن للاعتراف بما توصل اليه من العلم بعظيم جهله وإن نسبة معلوماته إلى مجهولاته نسبة القطرة إلى المحيط، وكان أكبر علمه جهله البسيط وقد سئل إفلاطون حين أشرف على الرحلة الأبدية عن الدنيا فقال: ما أقول في دار جئتها مضطراً وها أنا أخرج منها مكرها وقد عشت فيها متحيرا ولم أستفد فيها من علمي سوى أني لا أعلم. وقال سولون الحكيم: ليس من فضيلة العلم سوى علمي بأني لا أعلم، ومن استقصى كلمات حكماء اليونان وغيرهم وجد لكل واحد منهم مثل هذه الكلمات والتشبع بهذه الروح السارية إلى متضلع في الفضيلة بروح الفضيلة من علماء الإسلام وحكمائهم حتى قال الشافعي:
وإذا ما ازددت علما***زادني علما بجهلي
والرازي يقول:
نهاية إدراك العقول عقال***وغاية سعي العالمين ضلال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا***سوى أن جمعنا فيه قيل وقال
في حين أن علماء الغرب وكبار المخترعين الذين حوروا الدنيا إلى هذا الشكل العجيب يعترفون بعدم وصولهم إلى حقائق الأشياء، فهم وإن اخترعوا الكهرباء لا يعرفون حقيقتها، هذا فضلا عن الروح والنفس والحياة، وهذا مجال لا يأتي عليه الحصر، فالإنسان عريق بالجهل لصيق بالعجز والحاجة ولا شقاء ولا بلية إلّا وهي منبعثة اليه من ذلك، وعقول البشر بالضرورة غير كافية لرأب هذا الصدع ونأي هذا الثلم وسد هذا العوز، فالعناية الأزلية التي أوجدت هذه الخليقة لو تركتها على هذه الصفة تكون قد أساءت اليها بإيجادها وما أحسنت الصنيع بنعمة الوجود عليها، ولكان أحرى لو
ص: 129
تركتها في طوامر العدم وأطمار الفناء، ويكون ذلك نقضا للحكمة وإفسادا للنعمة.
إذاً فلا بدّ من إيجاد رجال كاملين في أنفسهم مكملين لغيرهم، يكونون كحلقة الاتصال بين الخالق،والخلق وهمزة الوصل بين العبد،والرب فإن السعادة منه واليه، وأولئك هم السفراء والأنبياء الذين بهم تتم الحجة وتستبين المحجة، وحينئذ تكون سعادة كل إنسان وشقاؤه باختياره قال تعالى: «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»(1)، وقال: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا»(2)، وتكون حينئذ اللّه على الناس الحجة البالغة.
نعم وكل هذا موقوف على إثبات الصانع الحكيم المنزّه عن العبث والظلم، فضلا عن الجهل والعجز.
وهناك أدلى الشيخ بالحجة وأملى أصول البرهنة على وجود الإله الحق بعدة قواعد لا يساعدنا المجال لسردها وعدّها تفصيلا، ولكن نكتفي بالإشارة اليها على وجه الإجمال:
1 - قاعدة أن ما بالعرض لا بدّ أن ينتهي إلى ما بالذات
2 - إن معطي الشيء لا يكون فاقده.
3- إن الصدفة في النواميس الطبيعية الكلية والأشياء المتكررة مستحيلة.
4 - إمكان الأشرف.
5 - قاعدة اللطف
وأمثال ذلك من أمهات قواعد الحكمة و أصول الفلسفة الحقة، ثم ارتأى في هذا المقام أن يختم البحث لضيق الوقت وهكذا كان(3).
وعندما نزل الشيخ من المنبر دارت بينه وبين أحمد أمين أحاديث لا مجال لعرضها هنا.
ص: 130
ويصف عبد الوهاب عزام من الوفد الزائر ذلك المجلس في أحد كتبه فيقول بعد أن يتحدث عن الشيخ ومجلسه ثم اقترح عليه بعض الحاضرين أن يشهدنا بعض دروسه، وألحوا عليه فأجاب الدعوة إكراما لضيوفه جزاه اللّه خير الجزاء.
جلس الأستاذ العلامة على كرسي، وأحاط به طلابه وكلهم رجال تلوح عليهم سن الأربعين أو ما يقرب منها، وكلهم وقور في سمته وبزته تكلّم في مسألة من علم الكلام، مسألة واجب الوجود، ثم ثنّى بتفسير الآية «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ» والطلبة في أثناء ذلك يسألون ويجادلون، قد رفعوا الكلفة بينهم وبين شيخهم. وقد سمعنا المعجب من بيان الأستاذ وغزارة علمه على قصر الوقت(1).
ويمكن في هذا المثال ملاحظة عمق استحضار أستاذ البحث الخارج لمطالبه بحيث أنه وافق مباشرة على طلب تدريس درس من دروسه ارتجالا من دون إعداد لمادة الدرس ومبحثه، وزاد على ذلك فنزل عند رغبة زائريه فوافق على تحويل مادة ومبحث الدرس من علم إلى علم آخر ارتجالا كذلك، وهو علم الكلام، فأحسن العرض والمناقشة في العلمين الدقيقين معا.
كما يمكن استيضاح مدى إحاطة أستاذ بحث الخارج بعلوم اللغة والمنطق والفلسفة والبلاغة وتاريخ الفلسفة وهي من علوم المقدمات وحسن توظيفها في مجال علمي الفقه والكلام من خلال الاستعانة بهما في استنباط الأحكام الشرعية وفي الدلالة على وجود اللّه. ويمكن أيضا ملاحظة استعانته بعلم الأصول في بيان مبحثه الفقهي مع حسن استحضاره ودقة حفظه لآيات القرآن الكريم وكثرة استشهاده بها واستدلاله بنصوصها على المدعى، إضافة إلى أمور أخرى يمكن استفادتها من الدرسين كليهما مما لا يسع المجال للوقوف عندها في هذه العجالة.
ص: 131
ص: 132
(1) دراسة المرجع الشيخ الفياض عن أستاذه السيد الخوئي. مجلة النور. العدد 176 لسنة 2006م: 92
(2) موسوعة النجف الأشرف جامعة النجف الدينية : 6 / 207. نقلا عن جامعة النجف. الشيخ محمد تقي الفقيه
(3) المصدر السابق : 6 / 207 – 208.
(4) ينظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة. الشيخ أغا بزرك الطهراني : 4 / 366 وما بعدها.
(5) ينظر : دروس في أصول فقه الإمامية. الدكتور عبد الهادي الفضلي : 1/ 31 وما بعدها.
(6) ينظر مرجعية التقليد سابق : 135 هامش رقم 1.
(7) أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف سابق : 266.
(8) ينظر : مرجعية التقليد. سابق : 135
(9) الأحلام. سابق : 263.
(10) الذريعة إلى تصانيف الشيعة. الشيخ أغا بزرك الطهراني : 4 / 367.
(11) من مقدمة كتاب كفاية الأصول للشيخ الخراساني. بقلم السيد جواد الشهرستاني : 21
ص: 133
(12) المصدر السابق
(13) أدوار الفقه الإسلامي الإمامي. الشيخ محمد إبراهيم الجنّاتي. بحث. مجلة الفكر الإسلامي. 2/ 126 لسنة 1415ه.
(14) ماضي النجف وحاضرها. سابق : 3 / 200.
(15) أحد أبناء الشيخ جعفر الأربعة المجتهدين تولى زمام المرجعية بعد وفاة أبيه الشيخ وأخيه الشيخ موسى وكان ورعا تقيا مواظبا على الطاعات دائم العبادة والذكر، وكان لا تأخذه في اللّه لومة لائم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان إضافة لذلك شاعراً مجيداً ومحدثاً بارعاً درس على أبيه الشيخ ثم أخيه الشيخ موسى، وقد تخرج على يديه الكثير من العلماء الفطاحل يأتي في مقدمتهم الشيخ مرتضى الأنصاري والمير فتاح صاحب العناوين والسيد مهدي القزويني والشيخ مشكور الحولاوي له من الكتب والمصنفات الكثير : كتاب في الخيارات وله رسائل عديدة وله أيضا تعليقة على رسالة والده.
(16) ماضي النجف وحاضرها 3 / 169.
(17) نظرة في علم الأصول في حوزة النجف. حوار مع المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض. منشور في مجلة التحقيق والحوزة. عدد خاص بحوزة النجف الأشرف من دون ذكر رقم العدد السنة الرابعة : 104.
(18) من مقدمة كتاب كفاية الأصول للشيخ الخراساني. سابق. ص: 19. نقلا عن مجلة العلم. العدد 8 من السنة الثانية. شهر صفر من سنة 1330 ه- ص: 341
(19) المصدر السابق: 19۔20 نقلا عن كتاب تاریخ روابط إيران والعراق: 265
(20) نشرها أيضا الباحث علي الخاقاني في الجزء السادس من موسوعته شعراء الغري وذلك في الصفحات:104-112، ثم أعاد نشرها الأستاذ علاء أل جعفر في
ص: 134
مقدمته للطبعة الثانية المحققة من كتاب أصل الشيعة و أصولها للشيخ آل کاشف الغطاء وذلك في الصفحات: 79 وما بعدها، ونشرت أيضا في مقدمة السيد محمد علي القاضي الطباطبائي لكتاب ( جنة المأوى) للشيخ كاشف الغطاء في الصفحات 28-32، ثم أعاد نشرها الدكتور الشيخ محمد حسين الصغير في كتابه أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف: 182-193.
(21) سورة الأنعام: 152.
(22) سورة الأنعام: 151
(23) سورة النساء: 43.
(24) سورة البقرة : 35.
(25) سورة التوبة : 28.
(26) سورة البلد: 10.
(27) سورة الإنسان 3.
(28) نقلا عن مقدمة كتاب جنة المأوى للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. بقلم: السيد محمد علي القاضي الطباطبائي : 28-32
(29) رحلات عبد الوهاب عزام: 62 وما بعدها.
ص: 135
ص: 136
الاجتهاد
يتضمن هذا الفصل مباحث أربعة هي:
المبحث الأول : الاجتهاد في المعجم العربي وفي المصطلح.
المبحث الثاني : معدات الاجتهاد الشرعي.
المبحث الثالث: شهادة خريج حوزة النجف الأشرف.
المبحث الرابع: برنامج يوم عمل لأستاذ مجتهد في حوزة النجف الأشرف.
ص: 137
ص: 138
الاجتهاد في المعجم العربي مشتق من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما، وهو لا يكون إلّا في الأشياء التي في حملها ثقل، فيقال مثلا إن فلانا اجتهد في حمل صخرة، بينما لا يقال أن فلانا اجتهد في حمل ورقة.
أما الاجتهاد في المصطلح فقد نشب خلاف بين العلماء في تعريفه وتحديده، والأنسب في تعريفه بمفهومه العام أن يقال بأنه ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو عقلية، وهذا التعريف منتزع مما تبنته مدرسة النجف الأشرف الحديثة في علم الأصول(1)، والمجتهد هو من تتوفر فيه هذه الخصيصة.
أو هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة، وهي القرآن الكريم والسنة بمعونة القواعد الأصولية المستدل على صحتها وفقا للأسس الموضوعة، بعد دراسة العلوم التي تساعد على ذلك. وبموجب ما تقدم فلا يدخل القياس ولا الاستحسان ولا المصالح المرسلة ولا العرف ولا شرع من قبلنا ولا مذهب الصحابي ولا الاعتماد على الرأي الشخصي لبطلانها. ويقال للقادر على استخراج الأحكام من مصادرها (مجتهد).
فإذا انتهى طالب الحوزة العلمية من دراسة المقدمات دراسة مستوعبة، ثم أعقبها بدراسة السطوح دراسة معمقة، ثم أنهى مرحلة البحث الخارج بتدقيق وتحقيق، فقد
ص: 139
تأهل لدخول مرحلة الاجتهاد من خلال البحث في الأدلة التفصيلية بشكل واسع ومعمق ليختار منها ما يسوقه إليه اجتهاده في المسائل التي تعرض له أو يسأله غيره عنها. فإذا وجد الباحث المجد المستقصي ممن أنهى مرحلة البحث الخارج في نفسه بصدق وإخلاص وتجرد وصفاء نية وقصد قربة للّه عز وجل القدرة على البحث المعمق في المسائل الفقهية والأصولية واستقصاء الأدلة من مصادرها، ودقة تحليل النصوص، ومناقشة الآراء المختلفة فيها بعمق وإرجاع الأدلة الظنية منها إلى أدلة قطعية ومن ثم الوصول إلى رأي مستقل يذهب إليه فيما يبحث ويناقش ويتبناه ويحسن الدفاع الرصين عنه، عدَّ آنذاك مجتهداً.
و من الأهمية بمكان تبيان أن المجتهد ليس من يستطيع النقض والإبرام ثم يخصم بسرعة، بل هو الذي يستطيع المتابعة حتى النهاية على وجه يستطيع إرجاع كل دليل ظني إلى قطعي مهما طالت السلسلة، أما الذي يرجع الدليل الظني إلى مثله، ثم يدعمه بقوله أفتى به فلان أو قاله فلان أو ذكره جماعة فهو يستدل على الظني بمثله وعلى النظري بالنظري، ومثله يعتبر جهلاً في جهل وليس لصاحبه في ميزان التحقيق نصيب من العلم(1).
هذا و من الجدير بالذكر أن ما جعل الاجتهاد في مذهب أهل البيت يمتاز عن غيره هو صدور القواعد الأصولية والفقهية الكثيرة التي يعتمد عليها الاجتهاد من الائمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) وخاصة الإمامين : محمد بن علي بن الحسين الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)، فإن الروايات الدالة على الاستصحاب، والبراءة الشرعية، وقاعدة اليد، والسوق، وأصالة الصحة (أي حمل فعل المسلم على الصحيح)، وأصالة الطهارة، وأصالة الحل (الإباحة)، وقاعدتي لا ضرر ولا حرج، وكيفية ترجيح الروايات المتعارضة، وعشرات القواعد الأخر كلها دالة على إحاطة الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) بهذه القواعد، وتعليمهم الفقهاء لها،
ص: 140
وإن كانت العناوين والتسميات قد ظهرت بعد ذلك، فالاستصحاب تدل رواياته على واقع الاستصحاب وهو (جرّ الحالة السابقة من حيث الحكم أو الموضوع) وإن لم يطلق عليه عنوان الاستصحاب آنذاك. وكان الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) يربون تلاميذهم كلّا في فرعه الخاص به، فكانوا يعلمون الكلاميين منهم كيفية المناظرة، والفقهاء كيفية الاستنباط، فقد سأل الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) سائل عن المسح على مرارة وضعها على ظفره المقطوع، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يعرف هذا واشباهه من كتاب اللّه عزّ وجلّ قال اللّه تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج»(1) امسح عليه»(2).
عند
وقد ورد عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قوله : «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع»(3) أما ماورد عنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) من رفض الاجتهاد فالمقصود منه رفض ما كان متعارفا عند غيرهم آنذاك من الأخذ بالرأي والعمل بالقياس والاستحسان لا الاجتهاد بالمعنى المتقدم.
ويوضح باحث من غير أتباع مذهب أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وهو يتحدث عن الاجتهاد أتباع المذاهب الأخرى مميزا بينه وبين الاجتهاد في مذهب أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) بقوله: إن الصورة المتوارثة عن جهابذة أهل السنة أن الاجتهاد قفل بأئمة الفقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل هذا إذا عنينا الاجتهاد المطلق أما ما حاوله الفقهاء بعد هؤلاء من اجتهاد لا يعلو أن يكون اجتهادا في المذهب أو اجتهاداً جزئيا بالفروع، وأن هذا ونحوه لا يكاد يتجاوز عند أهل السنة القرن الرابع بحال من الأحوال، أما ما جاء عن الغزالي في القرن الخامس وأبو طاهر السلفي في القرن السادس وعز الدين عبد السلام وبن دقيق العيد في القرن السابع وتقي الدين السبكي والمبتدع في القرن الثامن والعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في القرن التاسع فإن هذا ونحوه لا يتجاوز في نظر المنهج العلمي الحديث باب الفتوى ولا يدخل في شيء من الاجتهاد.
أما علماء الشيعة الإمامية فإنهم يبيحون لأنفسهم الاجتهاد في جميع الصور التي
ص: 141
حدثناك عنها ويصرن عليه كل الإصرار ولا يقفلون بابه دون علمائهم في أي قرن من القرون حتى يومنا هذا وأكثر من ذلك نراهم يفترضون بل يشترطون وجود المجتهد المعاصر بين ظهرانيهم ويوجبون على الشيعة إتباعه رأسا دون من مات من المجتهدين وليس هذا غاية ما يلفت نظري أو يستهوي فؤادي في قولهم بالاجتهاد، وإنما الجميل الجديد في هذه المسألة أن الاجتهاد على هذا النحو الذي نقرأه عنهم يساير سنن الحياة وتطورها ويجعل النصوص الشرعية حية متحركة نامية متطورة تتمشى مع نواميس الزمن والمكان فلا تجمد ذلك الجمود الموصد الذي يباعد بين الدين والدنيا أو بين العقيدة والتطور العلمي وهو الأمر الذي نشاهده في أكثر المذاهب التي تخالفهم.
ص: 142
معدات الاجتهاد الشرعي عديدة منها ما يتصل بالقدرة على تفسير القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع وبالأخص ما يتعلق بآيات الأحكام منه بحيث يتعرف الباحث على الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، ومنها الإحاطة الوافية بالأحاديث الشريفة التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، ومنها القدرة على تحقيق نسبة النص إلى قائله، كأن تكون للباذل جهده كي يحوز على ملكة الاجتهاد خبرة بعلم الجرح والتعديل بما يضمن له التأكد من سلامة رواة الحديث ووثوقهم فيما ينقلون، وأن يكون على دراية بتحقيق النصوص والتأكد من سلامتها من الخطأ أو التحريف، وعلى علم ومعرفة بمصادر النصوص الشرعية ومظانها المتعددة التي تعينه على الوصول لغرضه العلمي، وأن يكون مؤهلا لالتماس الحجية للروايات من قبل الشارع المقدس باعتبارها من أخبار الآحاد التي توجب القطع بمضمونها، وذا خبرة بالمرجحات التي جعلها الشارع المقدس أو أمضاها في حالة التعارض بينها.
ومن معدات الاجتهاد أيضا ما يتصل بالعلوم المساعدة التي لابدّ لمن أراد الاجتهاد أن يستوعبها ومن أهمها أن تكون له خبرة لغوية تؤهله لأن يفهم مواد الكلمات ويؤرخ لها على أساس زمني، وأن يكون على علم بوضع قسم من الهيئات والصيغ الخاصة كهيئات المشتقات وصيغ الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد
ص: 143
وغيرها، وعلى معرفة واسعة بمسائل النحو والتصريف، وقدرة عالية في فهم أساليب العرب من وجهة بلاغية وتقييمها وإدراك جملة خصائصها، وهذا ما لا يتأتى في الغالب من دراسة كتب البلاغة التقليدية لانشغالها عن مهمتها الأساسية بمماحكات لفظية، أما التماس النصوص البليغة ودراستها وتقييمها فهذا ما لا يتفق أن تعنى به إلّا نادرا، وبما أن أهم مصادر التشريع عندنا هما الكتاب والسنة، وهما في أعلى مستويات البلاغة، وبخاصة القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة، فإن فهمهما مما يحتاج إلى حس بلاغي لا يتوفر إلّا في القليل من البلغاء ممن تكوّن لديهم ذلك الحس بفضل تتبع واستظهار وتقييم كثير من النصوص البليغة في عصر القرآن وغيره.
ومن معدات الاجتهاد كذلك الإحاطة التاريخية بالأزمان التي رافقت تكوّن السنة، وما وقع فيها من أحداث، كي يستطيع الباحث أن يضع النصوص التشريعية في موضعها الزمني وفي أجوائها وملابساتها الخاصة، ومن هنا تنبع أهمية معرفة أسباب النزول في الكتاب العزيز والبواعث لتبليغ التشريع في السنة إن كانت لما يلقيان من أضواء على طبيعة الحكم، وأن تكون لمريد الاجتهاد خبرة بأساليب الجمع بين النصوص كتقديم الناسخ على المنسوخ والخاص على العام والمطلق على المقيد وكالتعرف على موارد حكومة بعض الأدلة على بعض، أو ورودها عليها.
وأخيرا وليس آخرا أن يكون الساعي لتحصيل ملكة الاجتهاد على ثقة بعد اجتياز المرحلة السابقة وتحصيل ظهور النص بحجية مثل هذا الظهور.
هذا كله بالنسبة إلى الطرق الكاشفة عن الكتاب والسنة، أما الطرق الأخرى الكاشفة عن الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية من غير طريقها، فحسب الفقيه أن يحيط بما حرر في كتب الأصول الموسعة ليعرف الحجة منها من غير الحجة، ويعرف أيضا موارد جريانها و أصول الجمع بينها، ولا يقتصر في ذلك كله على الأخذ برأي فريق دون
ص: 144
فريق، بل يمحصها جهده ويكوّن لنفسه رأيا لأن التقليد في أصول الفقه محق للاجتهاد من أساسه.
إن ملكة الاجتهاد إنما تنشأ من الإحاطة بكل ما يرتكز عليه قياس الاستنباط، سواء ما وقع منه موقع الصغرى لقياس الاستنباط كالوسائل التي يتوقف عليها تحقيق النص وفهمه، أو كبراه كمباحث الحجج والأصول العملية. كما ان سالك طريق الاجتهاد لا يمكن أن يبلغ مرتبته حتى يمر بها جميعا ليكون على حجة فيما لو أقدم على إعمال هذه الملكة. فالذي يعرف مثلا وسائل تحقيق النص وفهمه دون أن يجتهد في معرفة بقية الحجج والأصول على نحو يكوّن لنفسه رأياً لا يتداخله الوهم أو الشك لا يسوغ له ادعاء الاجتهاد ولا استنباط حكم واحد لعدم المؤمن له من قيام حجة يجهلها من الحجج الأخرى على خلاف ما استفاده من النص وقد تكون سمة هذه الجهة المجهولة لديه سمة الحاكم أو الوارد على ذلك النص.
كما يُطلب من المجتهد كما يرى بعض الباحثين تحصيل القدرة على تحليل القضايا والوقوف على أبعادها ومعرفة موضوعاتها الواقعية لئلا تترتب الأحكام على غير موضوعاتها وكذلك معرفة أعراف المجتمع وعاداته وأوضاعه لتتناسب الأحكام التي يصدرها المجتهد مع الحالات السائدة في المجتمع فمثلا كان صمت المرأة في العصور الموروثة عند سؤالها عن رايها في الزواج دليلا على رضاها كما جاء في الحديث إذنها صمتها الذي كان مبتنياً على العرف السائد في عصر صدوره. إلّا أن المجتمع بات لا يكتفي في العصر الراهن بصمت المرأة في هذه الحالة وذلك لتغير العرف الذي يرى أن على المرأة الإعراب عن رضاها لفظا، ومنها المعرفة بأوضاع المجتمعات الأخرى ومتطلباتها وعلاقاتها وهذا الأمر يعين المجتهد كثيرا في استنباط المسائل المتصلة بالعلاقات الدولية ومنها معرفة الموضوعات الفقهية فإن الموضوعات التي لا تخضع
ص: 145
لدراسة دقيقة لا يمكن بيان أحكامها بصورة واضحة لأن الحكم تابع للموضوع كما أن العرض تابع للمعروض والحكم يحمل دائما على موضوع معين فإذا أحاط الإبهام بالموضوع كان الحكم المتعلق به مبهما أيضا فإن وضوح الموضوع يثمر حكما واضحا وإذا أظهرت الدراسات الجديدة حول موضوع معين حدوث تغير فيه أو في إحدى خصائصه الداخلية أو الخارجية فإن هذا يستدعي إصدار حكم جديد يتناسب والتغير الذي عرض للموضوع لذلك لا بد للمجتهد من مواكبة تطورات العصر ودراسة الموضوع ضمن ظروفه الزمانية والمكانية ومن الطبيعي أن هذا لا يعني لزوم معالجة الموضوعات من طرف المجتهد نفسه إذ يمكنه الاستعانة بأهل الاختصاص والخبرة في كل حقل من الحقول وأمثال ذلك.
هذا ويشترط في مَن يجوز تقليده الاجتهاد، ويثبت بالاختبار فيما إذا كان المقلِّد قادرا على تشخيص ذلك وبشهادة عدلين من أهل الخبرة، وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، وبالشياع ويقصد به أن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من الناس بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك ويمكن استكشاف الاجتهاد أو الأعلمية في من يتصدى للمرجعية بما دأب عليه العلماء وأهل الخبرة والمحققون السابقون واللاحقون، فقد كانوا ينظرون إلى عدة أمور وقضايا مهمة تعتبر مؤشرا لهذه الحقيقة:
أولها: ما يرتبط بأصل وجود هذا المستوى من العلم وهو الاجتهاد المطلق بالنسبة لمن يدعي المرجعية، ذلك أن المتصدي للمرجعية لا بدّ أن يكون مجتهدا معترفا به في المؤسسة العلمية المتخصصة، وهي الحوزة العلمية، بأن يتولد لدى علماء الحوزة العلمية ومدرسيها وفضلائها وطلابها رأي عام بقبول دعوى الاجتهاد المطلق للشخص المعين.
إن هذه القرينة العلمية المتبعة في كل شأن علمي يراد استكشاف مدعي تحصيله،
ص: 146
هي خير مائز بين المجتهدين الحقيقيين ومدعي الاجتهاد، ذلك أن أي درجة علمية عالية لا يمكن القبول بدعوى مدعيها ما لم يرجع إلى المؤسسة العلمية التي تخرج منها للوقوف على حقيقة دعواه، فالطبيب مثلا لا يمكن القبول بادعائه الحصول على مستوى عال من التخصص ما لم يكن هناك اعتراف بمستواه العلمي المتقدم من قبل المؤسسات الطبية والجامعات العلمية وزملائه الأطباء، وبدون هذا الاعتراف لا يمكن قبول دعوى من مدعي الحصول على هذه المرتبة الطبية العالية، وحال مدعي الاجتهاد في الفقه حاله حال مدعي التخصص العالي في الطب وغيره من العلوم الأخرى.
ثانيها: وجود الكتب العلمية التخصصية في الفقه و أصوله لهذا الشخص الذي يدعي المرجعية بحيث يستطيع الباحث المتخصص أو الخبير في الفقه و أصوله لا الشخص غير المتخصص أن يقيم مستواها العلمي الرفيع فيحكم على مؤلفها ويحدد مستوى فضله من خلال ما كتب وألّف.
ثالثها تخرج عدد من علماء الحوزة وفضلائها على يديه يشهدون له بالعمق العلمي والبحث الدؤوب والاجتهاد المطلق، ذلك أن طبيعة الحوزة العلمية هي طبيعة بحث مستمر وأخذ وعطاء، فالطالب فيها هو أستاذ لمن هو أدنى منه درجة علمية وهو في الوقت نفسه تلميذ عند من هو أعلى منه درجة علمية،وهكذا، وحين يشهد طلابه العدول الصادقون مع أنفسهم والمتقدمون في دراستهم باجتهاده وفضله العلمي، فإن هذه الشهادة توحي بالثقة بمستواه.
وقد دأب بعض الأساتذة المجتهدين على منح شهادة اجتهاد لبعض طلابهم المتميزين اعترافا منهم بفضلهم واجتهادهم ومستواهم العلمي.
ص: 147
ص: 148
جرت العادة أن لا تمنح الشهادة إلا لداع معتدّ به، وغالبا ما يكون ذلك عندما يعتزم الطالب العودة إلى بلده عودة نهائية بعد انتهاء دراسته في النجف الأشرف حيث تطلب نه الإجازة في بلده كتوثيق لمستواه العلمي، حينها يأخذون شهادات من أساتذتهم ومن الرئيس الديني (المرجع الأعلى) وتلك الشهادات تتضمن في اصطلاحاتها مقدار درجات حامليها، وهذه المصطلحات يعرفها الخاصة وهم بدورهم يعطون عن حامليها صورة إلى السواد، فهي نظير الشهادات التي يحملها طلاب الجامعات الحديثة فإنها تتضمن مصطلحات لا يفهمها إلّا القليل.
وعندما يريد الطالب الشهادة يرفع الأمر إلى أساتذته والى الرئيس الأعلى مباشرة أو بواسطة، فإن كانوا يعرفونه معرفة كاملة كتبوا له شهادات بخطوطهم ومن إنشائهم، فإن كان متميزا في ناحية أسهبوا في تلك الناحية، فإن كان متميّزا بالفضل نوّهوا بفضله، وإن كان متميّزا بالعقل نوّهوا بعقله، وإن كان متميزا بالورع نوهوا بورعه، وإن كان متميزا فيها كلها نوهوا بالجميع. يفعلون ذلك تعزيزا للعلم والدين والتماسا لرضا اللّه سبحانه، ويرون ذلك حقا من حقوق الطالب ومن حقوق المجتمع، فليقيموا الحجة بإرشادهم إلى اتباع من ينتفعون به باتباعه، وإن كانوا لا يعرفونه المعرفة الكافية، تعرفّوا عن عقله وفضله وتقواه ممن يثقون بدينهم وأمانتهم ولياقتهم للتمييز، فإن شهدوا له، كلفوا بكتابة ورقة تتضمن ما شهدوا به، وهم بدورهم يتحرجون من ذلك، لأن
ص: 149
الرقابة العامة توجه التبعات على من كتب فإن كان ما كتبه دون مستوى المكتوب له طولب بذلك، وإن كان فوقه كان الأمر كذلك. ثم إذا كتبت الورقة بقيت أياما عند من يطلب منه توقيعها، تبقى للرقابة والتدقيق وتكون خاضعة للتبديل والتعديل، فإن كانوا يعرفونه أعطوا رأيهم، وإلّا استمهلوا واشتغلوا بالتنقيب، والتدقيق، كل ذلك بشكل هادئ إلى الغاية، وبعد ذلك كله يضيف الرئيس إلى المسودة ما يريد أو يضرب على ما لا يرتضيه، ثم يأمر بتبيضها.
وفي هذه الفترة يبقى صاحب الحاجة منتظرا ويطلب توقيع الورقة، فيقال له وقت آخر لا داعي للعجلة المسألة تحتاج إلى ترو، متى عزمت على السفر؟ فيقول بعد أسبوع مثلا، فيقال له الوقت واسع.
فأنت ترى شدة حراجة الأستاذ في كتابته للشهادة ودقة تثبته وتدقيقه قبل منحها، وأنها لا تمنح إلّا بعد أن يطمئن أستاذ البحث الخارج أو أساتذته إلى قدرة الطالب العلمية والمعرفية لما ينوون منحه إياه، ويتأكد أو يتأكدوا من نبوغه في العلم وحيازته على ملكة الاستنباط فيما لو كانت الشهادة شهادة بالاجتهاد بحيث يتضح ذلك عند المرجع الأعلى مثلا من خلال تمكّن الطالب من مسك ناصية البحث والتحليل والاستنباط و مناقشة الأقوال ومحاكمة الآراء والانتهاء من الأدلة الظنية إلى الأدلة القطعية، مع القدرة على الدفاع العلمي الرصين عنها، ومن ثم صياغة أدلته ونتيجة أدلته صياغة فنية من خلال الجمع بين الأحاديث المتعارضة وترجيح بعضها على بعض بالأدلة المقنعة بعد تقليب وجوه الرأي في المسألة محل البحث حينذاك قد يشهد له أستاذه أو أساتذته بالاجتهاد، فينتقل الطالب بعد قطع هذه المرحلة الطويلة من البحث والمتابعة والتحري والاستقصاء التي ربما تستغرق ربع قرن إلى الاجتهاد وإبداء الرأي التي هي عنده أغلى من كل نفيس ولا يكون فيها تمويه ولا تدليس ولا يحوز الشهادة منها بغير الكفاءة
ص: 150
الحقيقية والأهلية الثابتة.
وخلال هذه الفترة الطويلة المليئة بالجدية والنشاط والبذل والسعي والمشقة التي قضاها الطالب المحصل المصحوبة عادة بمتابعة أطراف من الثقافات والحضارات الأخرى التي قد لا تتصل برسالته في الصميم، إلا أنها كذلك ليست بعيدة عنها ما يضع الباحث المتابع لما تنتجه الحضارة اليوم على تماس مباشر بكل ما يعينه على تكوين وجهة نظر علمية رصينة فيما يتصدى له من قضايا معرفية في مجال اختصاصه من جهة، وغير بعيدة عن أجواء المعرفة المعاصرة في غير اختصاصه من جهة أخرى.
إنَّ الحوزة العلمية إذ توصل الطالب المجد إلى هذه المرحلة المتقدمة مرحلة الاجتهاد التي تمكنه من الإحاطة بمعارف الشريعة الغراء أصولاً وفروعاً من مصادرها المعتبرة، وبما تضعه بين يديه من آليات البحث والاستقراء والاستنتاج والاستنباط، تتيح له من التفتح الذهني والمعرفي ما يمكنه فيما لو استثمره الاستثمار الأمثل ورفده بمستجدات الحاضر أن يقدم خدمة نافعة للعلم وللمجتمع في آن.
وقد حرص ويحرص طلاب العلم على أن يدرسوا علومهم الدينية في حوزة النجف الأشرف كي يحوزوا شهادة الاجتهاد منها فمنذ القرن الثاني عشر ازدلفت إلى النجف من سائر اصناف الشيعة جمّ غفير وجعلوا يحثون الركاب اليها من كل فج وصوب ولا تنس ما يحدث بذلك من احتكاك الأفكار وتبادل الآراء وما ينتج منهما، ذاك النتاج الذي أثر في النجف أثرا خالدا حتى كساها سمعة في سائر العلوم أضعاف سمعتها الأولى وتقدمت بهم النجف تقدما باهرا محسوسا وطفقوا يتسابقون في مضمار الجد والاجتهاد لينالوا الشهادة من تلك الكلية الكبرى فإذا بلغ الطالب الغاية وحاز قصب السبق آب إلى وطنه وهو حامل تلك (الإجازة) العالمية الثمينة، فإذا حل بين ظهراني قومه نشر فيهم معارفه ولمعت في ربوعهم أنواره.
ص: 151
وهكذا انتشر خريجو الحوزة العلمية النجفية في أنحاء العالم الشيعي شرقه وغربه مما يصعب إحصاء توزيعهم الجغرافي إلا من خلال جهد متخصص تبذله مؤسسات مصممة لهذا الغرض.
أما طريقة كتابة إجازات الاجتهاد فهي مختلفة حسب طريقة الأستاذ نفسه، فبعض الأساتذة يميلون إلى الاختصار في الكتابة أكثر من بعضهم الآخر. ولكن الشيء المهم في الإجازة النص على بلوغ حاملها مرتبة (الاجتهاد).
ويحسن بي هنا أن أثبت نموذجين لإجازتين منها سبق أن منحتا للمرجع الأعلى اليوم سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، أولى هذه الإجازات منحت له من قبل أستاذه سماحة السيد الخوئي (قدّس سِرُّه)، وثانيهما من أستاذه الآخر سماحة الشيخ حسين الحلي (قدّس سِرُّه) وفيما يأتي نص الإجازتين:
1- نص إجازة الاجتهاد التي منحها إياه آية اللّه العظمى السيد الخوئي (قدّس سِرُّه).
«الحمد للّه رفع منازل العلماء حتى جعلهم بمنزلة الأنبياء وفضّل مدادهم على دماء الشهداء وافضل صلواته وتحياته على من اصطفاه من الأولين والآخرين وبعث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين.
وبعد فان شرف العلم لا يخفى وفضله لا يحصى قدر ورثة أهله من الأنبياء، ونالوا به نيابة خاتم الاوصياء (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ما دامت الارض والسماء وممن سلك في طلبه مسلك صالحي السلف هو جناب العالم العامل، والفاضل الكامل، سند الفقهاء العظام، حجة الإسلام السيد علي السيستاني ادام اللّه ايام افاضته وافضاله وكثر في العلماء العاملين امثاله فانه قد بذل في هذا السبيل شطراً من عمره الشريف معتكفاً بجوار وصي خاتم الأنبياء في النجف الأشرف على مشرفها آلاف التحية والثناء، وقد حضر أبحاثي الفقهية
ص: 152
والأصولية حضور تفهم وتحقيق وتعمق وتدقيق، حتى ادرك والحمد اللّه مناهج، ونال مبتغاه وفاز بالمراد وحاز ملكة الاجتهاد فله العمل بما يستنبطه من الاحكام فليحمد الله سبحانه على ما،اولاه وليشكره على ما حباه.
وقد اجزته ان يروي عنّي جميع ما صحت لي روايته من الكتب الاربعة التي عليها المدار (الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار) والجوامع الاخيرة: الوسائل ومستدركه والوافي والبحار وغيرها من مصنفات اصحابنا وما رووه عن غيرنا بحق اجازتي من مشايخي العظام باسانيدهم المنتهية إلى أهل البيت (عليهم افضل الصلاة والسلام) وأوصيه دامت تاييداته بملازمة التقوى وسلوك سبيل الاحتياط فانه ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط وان لا ينساني من صالح الدعوات كما اني لا أنساه ان شاء اللّه تعالى والسلام عليه ورحمة اللّه وبركاته».
أبو القاسم الموسوي الخوئي
حررت في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1380ه/ 1961م
(تنظر صورتها الخطية في الملحق الرابع)
2- نص إجازة الاجتهاد التي منحها إياه آية اللّه الشيخ حسين الحلي (قدّس سِرُّه).
«الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. وبعد فان فضل العلم لا يخفى و به تنال السعادة الابدية العظمى وممن بذل الهمة في تحصيله وصرف على ذلك برهة من عمرة جناب الثقة العلامة المحقق حجة الإسلام السيد علي نجل المرحوم العالم المقدس الحاج السيد محمد باقر الحسيني السيستاني الخراساني طاب ثراه، فان جنابه قد حضر ابحاثي سنين عديدة حضور تفهم وتحقيق، وتامل وتدقيق، مجداً في تحريرها مجيداً في تحقيقها، وقد كثرت المذاكرة معه فوجدته بالغاً مرتبة الاجتهاد
ص: 153
وقادر على الاستنباط، فله العمل بأنظاره في المسائل الشرعية والاحكام الفرعية على حسب الطريقة المعروفة التي جرى عليها مشايخنا العظام واساتذتنا الكرام (قدس اللّه اسرارهم) وقد اجزت الجنابه ان يروي عني كل ما صحت لي روايته باسنادي عن مشايخنا العظام قدست اسرارهم، وأوصيه بملازمة التقوى وطريق الاحتياط وارجوه ان لا ينساني في الدعاء والسلام عليه ورحمة اللّه وبركاته».
17 ذق سنة 1380ه / 1961م
الأقل حسين الحلي
(تنظر صورتها الخطية في الملحق الرابع)
ص: 154
كثيرا ما يستغرق العمل العلمي جل وقت الأستاذ المجتهد في حوزة النجف الأشرف مستوعبا أطراف نهاره وآناء ليله لما عرفت به حوزة النجف الأشرف من أصالة وعمق وسعة بحث وتدقيق وكثرة تمحيص وتحقيق، وليس أدل على ذلك مما تناوله برنامج يوم عمل لأستاذين من أساتذتها الحاليين هما سماحة الشيخ باقر الإيرواني (حفظه اللّه) وسماحة الشيخ محمد سند حيث أجابني كل منهما مشكورا عن سؤالي المتعلق ببرنامج يوم عمل دراسي من أيام اشتغاله العلمي واعتذر آخرون، ولكل عذره وظروفه
وفيما يأتي برنامج يوم عمل كل منهما مبتدئا ببرنامج سماحة الشيخ باقر الإيرواني:
قال الشيخ الإيرواني جوابا عن سؤالي عن برنامج يوم عمله أيام اشتغاله بما نصه:
عشقت الكتاب والعلم منذ فتحت عيني وأنا أعيش في أحان حوزة النجف الأشرف فدرست و درست وتعلمت وعلمّت حتى درّست الكتاب الأصولي المعروف (كفاية الأصول) عشرين دورة تقريبا وقد ضبط على الكاسيت والسيديات ثلاث دورات منها أو أكثر.
أنا الآن اليوم أدرس في حوزة النجف الأشرف كل يوم أربعة دروس صباحاً،
ص: 155
وبعد الظهر أشرف على اجتماع علمي يضم بعض الفضلاء بهدف التدريب العملي على الأبحاث العلمية.
وقد جرت عادتي على الاستيقاظ مبكراً فترة الصباح، وبعد أداء مراسيم العبادة أمارس من جديد تحضير الدروس التي أريد إلقاءها حيث إني أمر بمراحل ثلاث في عملية التحضير للدرس
المرحلة الأولى: أقوم بها في فترة التعطيل الصيفي، حيث أحاول تحضير جميع المادة التي أريد إلقاءها خلال السنة الدراسية القادمة ثم أقوم بضبطها في دفتر خاص، ذلك أن الفترة في يوم إلقاء المحاضرة لا تسع لتحضير أربعة دروس ذات مستوى عالٍ، إذا أن تحضير محاضرة واحدة قد يستدعي أحيانا يوما كاملاً، بل أياماً. فكيف إذا كانت المحاضرات في كل يوم أربع.
وقد أحتاج أحيانا في البحث عن حديث واحد من حيث سنده ودلالته إلى ساعات.
إضافة إلى أن المسألة ليست مسألة تجميع من هنا وهناك بل مسألة تفكير وتأمل بالموضوع بالكامل لمناقشة الآراء الأخرى في المسألة والتوصل إلى رأي فيها.
والمرحلة الثانية أقوم فيها بالتحضير ليلاً، أي قبل يوم المحاضرة، والتحضير في كل ليلة يتم بمقدار المحاضرة التي يراد إلقاؤها في اليوم التالي، وقد يتم التوصل إلى اشياء مستجدة لم يتم التوصل إليها في المرحلة السابقة. وفي صباح اليوم الجديد بعد أداء مراسيم العبادة أبدأ بالمرحلة الثالثة حيث استحضار كامل للمحارة من جديد وترتيب لمنهجيتها وكيفية إلقائها وسد ثغراتها.
وبعد انتهاء التحضير المذكور وتناول وجبة افطار سريعة اذهب إلى مجلس الدرس الأول الذي يبدأ في الساعة السابعة صباحاً، والدرس الأول هو (خارج الفقه)
ص: 156
ويستغرق عادة فترة أربعين دقيقة، ثم في الساعة الثامنة اشرع بتدريس (خارج الأصول) والفترة المتخللة بين الدرسين أتركها للأخوة الطلبة لطرح اسئلتهم وإشكالاتهم ونقاط الغموض بمادة المحاضرة التي استمعوا إليها والجواب عنها (ينظر الملحق الخامس)، ثم في الساعة التاسعة أشرع بدرس (المكاسب) وفي الساعة العاشرة أشرع بدرس (كفاية الأصول)، وفي الفترات المتخللة بين كل درس ودرس يطرح الإخوة الحضور أسئلتهم كما كان شأن الذين سبقوهم من طلاب البحث الخارج، ثم بعد الانتهاء من الدرس الأخير أبقى لابثاً في قاعة المحاضرة لفترة نصف ساعة وربما تزيد أحياناً لاستقبال الأخوة سواء أكانوا من حضار الدرس ام من الناس الآخرين للجواب عن أسئلتهم أو حل بعض مشاكلهم.
وبعد الرجوع للبيت قبل الظهر أشرع مباشرة بكتابة ما بدأت به من بحوث، وقد تستغرق الكتابة تلك أحياناً ثلاث ساعات أو أربع متواصلة أقطعها عادة بعد أن يحل وقت الظهر لأداء مراسيم العبادة حتى إذا انتهيت منها اشتغلت من جديد وبسرعة في مواصلة كتابة شرح الكفاية.
وقد جرت العادة عند تناولي وجبة طعام الظهر أن أقوم بسماع نشرة الأخبار من خلال التلفاز للاطلاع على الأخبار العالمية وبخاصة ما يجري منها على الساحة العراقية ثم بعد انتهائي من وجبة طعام الظهر أواصل الاستمرار في كتابة شرح الكفاية حتى حلول الساعة الرابعة من بعد الظهر حيث أذهب للإشراف على المحاضرة التي تختص ببعض الفضلاء وقبيل الغروب بنصف ساعة تقريبا أرجع إلى البيت بسرعة لأواصل تحضير دروس اليوم التالي وأبقى مستمرا في تحضيرها بعد أداء مراسيم صلاتي المغرب والعشاء حتى الساعة الحادية عشرة تقريبا وفي أثناء ذلك أحاول سماع نشرة الأخبار الليلية من خلال التلفاز.
ص: 157
وليس من عادتي تناول وجبة عشاء، بل أتناول شيئا يسرا امتثالاً للأدب الشرعي. وفي يوم الأربعاء الذي هو آخر الأيام الدراسية في الأسبوع أقوم قبل انتهاء الدرس الأخير بإلقاء محاضرة أخلاقية على الأخوة الحضور بهدف حراسة الجانب المعنوي والمحافظة عليه.
وفي يومي الخميس والجمعة استقبل صباحاً إلى الظهر الإخوة الطلبة وغيرهم للجواب عن أسئلتهم أو كل مشاكلهم وقضاء ما يمكن قضاؤه من حوائجهم.
وعصر الخميس أقصد الذهاب إلى كربلاء للتشرف بزيارة الإمام الحسين وأخيه العباس (عَلَيهِم السَّلَامُ). وفي ليلة الخميس من كل أسبوع أقصد مرقد سيدي الإمام أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) للتشرف بزيارته.
والفترة المتبقية من يومي الخميس والجمعة لا أتركها تذهب سدى، فليس لي وقت زائد حتى يمكن أن يذهب سدى بل أقوم بالإجابة على الأسئلة التي توجه إلي أو بمطالعة بعض الكتب أو النشرات التي تهدى إلي، وأحاول أيضا مواصلة كتاباتي حول المنهج الجديد البديل عن مرحلة المكاسب فإني وفقت بحمد اللّه سبحانه لكتابة بعض الكتب لطلبة الحوزة العلمية وهي مورد استفادتهم.
والكتب التي تم إنجازها لحد الآن هي كما يلي
1. (الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني) وهو يقع في أربعة أجزاء وهو شرح لكتاب الحلقة الثالثة من حلقات السيد الشهيد محمد باقر الصدر في علم الأصول.
2. (دروس تمهيدية في القواعد الفقهية)، وهو جزءان، ويشتمل على أهم القواعد الفقهية التي يحتاج إليها طالب العلم خلال دراسته.
3. (دروس تمهيدية في القواعد الرجالية)، وهو يشتمل على أهم الأبحاث
ص: 158
الرجالية التي يحتاج إليها طالب العلم خلال دراسته.
4. (دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام) وهو جزءان يشتمل على توضيح الآيات الكريمة المرتبطة بالأحكام الشرعية.
5. (دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي)، وهو ذو أجزاء ثلاثة ويصلح أن يكون بديلاً عن كتاب (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) وقد أخذ هذا الكتاب الأخير يشق طريقه في حوزة النجف الأشرف وحوزتي الأحساء والقطيف.
6. كتاب (كفاية الأصول في أسلوبها الثاني) في خمسة أجزاء ما يصلح أن يكون بديلاً عن مرحلة الكفاية في أصول الفقه.
7. كتاب (الفقه الاستدلالي) في جزئين ما يصلح أن يكون بديلاً عن مرحلة المكاسب، وقد خصصت الجزء الأول منهما لفقه العبادات، وخصصت الجزء الثاني منهما لفقه المعاملات.
كما طبع من أبحاثي خارج الفقه بعض الأخوة الحضور من الفضلاء كتابين هما :
1. (البشارة في شرح كتاب الإجارة) وهو بحثي الخارج في كتاب الإجارة.
2. (فقه البنوك) وهو بحثي الخارج عن بعض أحكام البنوك.
والمحاضرات التي ألقيها في الخارج أو في السطوح قد تم تسجيل أكثرها ويتداولها الأخوة من طلبة الحوزات العلمية.
وقد تم تسجيل آخر دورة من درس (كفاية الأصول) في النجف الأشرف بعد سقوط النظام السابق بعدد من المحاضرات بلغت (425) محاضرة مسجلة على (CD).
ص: 159
وأما (المكاسب) فيقرب من (900) محاضرة (والرسائل) فيقرب من (600) محاضرة وقد سجلت دروسي في تفسير آيات الأحكام، والقواعد الفقهية، والقواعد الرجالية، وفي شرح التجريد، وبداية الحكمة وغير ذلك. كما سجلت لي محاضرات في (الشرائع) و (المكاسب) من قبل الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن. كما سجلت لي محاضرات كثيرة أخلاقية يرتبط بعضها بخطب أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في نهج البلاغة وبعضها بالقران الكريم وبعضها الآخر بموضوعات عامة كنت قد ألقيت الكثير منها في شهر رمضان المبارك بعد أداء صلاة الظهر جماعة ويبث الكثير منها من بعض الإذاعات في هذه الدولة أو تلك.
قال الشيخ محمد سند جوابا على سؤالي عن برنامج يوم عمل له بما نصه:
البرنامج اليومي الذي أطوية في الحياة العلمية الحوزوية في النجف الأشرف كالتالي:
عند استيقاظي في الصباح الباكر والإفاقة من الغفوة القصيرة بعد تعقيبات صلاة الصبح هو بالتحضير للدروس التي سألقيها مع تناول مقدار تناول مقدار يسير من الإفطار كي لا يعيقني عن حيوية ونشاط التفكير، ثم أتوجه إلى موضع التدريس فألقى ثلاث دروس
الأول: البحث الخارج في علم أصول الفقه والذي هو عبارة عن الدورة الثانية التي ألقيها على مسامع أهل الفضيلة والعلم حيث استغرقت الدورة الأولى خمسة عشرة سنة وها أنا ذا في السنة الثانية من الدورة الجديدة.
الثاني: البحث الخارج في علم الفقه على متن كتاب العروة الوثقى كتاب الصلاة بعد ما انتهيت طيلة السبعة عشرة سنة من بحث كتاب الاجتهاد والتقليد وكتاب
ص: 160
الطهارة وكتاب صلاة المسافر من الكتاب المزبور (ينظر الملحق السادس).
الثالث : البحث المقارن العقائدي على كتاب (أصول الكافي) للمرحوم الكليني، وأتناول في هذا البحث المقارنة والمحاكمة بين المدارس الاعتقادية في بحوث المعارف سواء الفلسفية القديمة والحديثة الغربية أو الكلامية والتفسيرية أو العرفانية المعنوية واستعراض الإثارات الفكرية المختلفة المعاصرة، ويتم بعد كل درس المتابعة مع الأخوة الحضور حول النقاط المطروحة في الدرس وتجاذب الحديث بالسؤال منهم والجواب مني عن أبعاد المحاور الموضوعية المطروحة، كما استقبل بعد الدرس الثالث وحوار الحضور مختلف الشرائح الاجتماعية لاسيما الجامعية الأكاديمية وأتلقى اسئلتهم في مختلف المجالات وربما كانت عن الموضوعات التي اتناولها في المحاضرات التي تبث لي في الفضائيات المتعددة، ثم بعد ذلك ربما أوفق لزيارة مرقد الإمام أمير المؤمنين علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) قبيل الظهر ثم اتجه لإقامة صلاة الجماعة في احد الجوامع وبعد تناول وجبة الغداء وسماع ما يتسنى من الاخبار أقضي فترة من الراحة ثم أباد في أول العصر لاستقبال عدة قليلة من الأفاضل لإدارة جلسة فقهية خاصة يتم فيها تنقيح الأدلة حول جملة من المسائل الفقهية في الأبواب وأسلوب العمل في الجلسة بنحو ورشة العمل و بنحو المشاركة، وان كانت هذه الجلسة في السابق اعقدها بعد صرتي المغرب والعشاء أو قبيل صلاة الظهر ووقت العصر مخصص لديّ لإقامة جلسة في تفسير القرآن على منهج خاص يختلف عن منهج التفسير الموضوعي وان اشترك معه في بعض الامتيازات.
وبعد صلاتي العشائين أقضي في بعض الليالي مع بعض الأخوة مراجعة بعض المدونات التي قرروها لبحوث متنوعة كنت قد ألقيتها وفي بعض الآخر من الليالي استقبل بعض اللقاءات لمواعيد مسبقة.
وبعد ذلك اتفرغ للتحضير والكتابة وتناول شيء من طعام العشاء.
ص: 161
واما ليالي وايام التعطيل كالخميس والجمعة أو بعض المناسبات فأقيم ليلاً بحث فقهي تعطيلي مشاركي مع الأخوة الحضور مع طبيعة ذلك اليوم وقد انجزت جملة من الكتب الفقهية المطولة في سلسلة أيام التعطيل كدورة استدلالية في الحج وقد طبعت ودورة في كتاب النكاح مما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية كما انه لدي سلسلة جلسات متواصلة أيام التعطيل نتناول المسائل المستبعدة المستحدثة سواء في مجال المال والمصارف وقد طبع أو الطب وقد طبع أيضاً أو نظم الدولة وقد طبع أو مسائل الفلك الفقهية وقد طبع أيضاً أو نظم الدولة وقد طبع منه بعض الأجزاء.
وقد طبع لي مما كتبته بقلمي أو بقلم جملة من الفضلاء الحاضرين لدي في أبحاثي :
1. سند العروة الوثقى، شرح استدلالي لكتاب العروة الوثقى وقد طبع منه أحدى عشر جزءاً وهناك ثلاث أجزاء منه أخرى تحت الطبع أيضاً.
2. سلسلة من فقه المسائل المستحدثة
أ) ملكية الدولة
ب) الهيويات الفقهية وقد طبع ثلاث مرات
ج) فقه المصارف والبنوك وقد طبع ثلاث مرات
د) فقه الطب وقد طبع مرتين.
1. بحوث في مباني علم الرجال وقد طبع مرتين.
2. دعوى السفارة في الغيبة الكبرى جزئين وقد طبع الجزء الأول منه كراراً.
3. الشهادة الثالثة في الآذان والإقامة.
4. الإمامة الإلهية خمسة أجزاء، وقد طبع عدة مرات.
ص: 162
5. مقامات فاطة الزهراء (عَلَيها السَّلَامُ).
6. مقامات استنباط العقائد.
7. أسس النظام السياسي عند الإمامية.
8. عدالة الصحابة.
9. الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد.
10. الشعائر الدينية.
11. بحوث معاصرة في الساحة الدولية
12. سند الزيارة الجامعة الكبير.
13. الرأي الآخر في الوحدة والتقريب.
14. فقه علائم الظهور.
15. العقل العملي دورة في بحوث الاعتبار القانوني والأخلاقي.
وهناك مشاركات في ندوات علمية ولقاءات في الفضائيات أيضاً.
ص: 163
ص: 164
(1) الأصول العامة للفقه المقارن : 545. (باختصار).
(2) موسوعة النجف الأشرف جامعة النجف الدينية 6 / 207 نقلا عن كتاب جامعة النجف للشيخ محمد تقي الفقيه.
(3) سورة الحج: 78.
(4) وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة. الحر العاملي: 1 / 327
(5) المصدر السابق : 18 / 41.
ص: 165
ص: 166
يتناول هذا الفصل مباحث أربعة هي:
المبحث الأول : المرجع الديني وبعض طرائق التحقق من توفر الشروط فيه.
المبحث الثاني : المقلد الأعلم وطريقة انتخابه.
المبحث الثالث: مهمات المرجعية وإنجازاتها.
المبحث الرابع: برنامج يوم عمل لمراجع في حوزة النجف الأشرف.
ص: 167
ص: 168
سبق أن عرضت للاجتهاد في الفصل السابق وشروط المجتهد، فإذا تصدى المجتهد للإفتاء فيما انتهى إليه رأيه واجتهاده من مسائل فعمل المكلفون من غير المجتهدين بآرائه ورجعوا إليه فقلدوه فيها باعتباره الأعلم بموجب شهادة أهل الخبرة والتخصص عدّ مرجعا دينيا وقاضيا بين الناس بالقسط في أمورهم المختلفة، هاديا إلى الحق والهدى والصلاح، معلّما الكتاب والسنة والحكمة والشريعة مزكيا ومطهرا ما أمكنه قلوب المؤمنين من الزيغ والضلال والانحراف، حارسا للعقيدة الحقة، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، محافظا على بيضة الإسلام، مبينا الأحكام الشرعية لمقلديه، وربما متوليا ما استطاع لأمر الأمة في زمن الغيبة على خلاف بين الفقهاء في سعة هذه الدائرة وضيقها وفي دليلها ومدركها وهل أنها تقف عند حدود الأمور الحسبية والضرورات الشرعية التي لا يرضى الشارع المقدس بإهمالها وتركها من قبل خيار المؤمنين على نحو الجزم واليقين، أو أنها أوسع من ذلك. ثم ما هي حدود هذه السعة على تقدير القول بها.؟
ولعل لفظ المرجعية بهذا المعنى منتزع من لفظة ارجعوا الواردة في التوقيع الشريف المروي عن الإمام المنتظر (عَجَّلَ اللّهُ تَعَالَي فَرَجَهُ الشَریف) جوابا عن السؤال حول الموقف الشرعي بعد الغيبة فقد ورد في الحديث قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجّة اللّه على الناس»(1) كما سيأتي ذلك في الفصل القادم.
يشترط في من يجوز تقليده أو المرجع الديني من بين أمور أخرى غير الاجتهاد
ص: 169
والتقوى، والتعلق بحبل اللّه المتين، وحبه والخوف منه جل شأنه، والتنزه عن التعلق بأمور الدنيا الفانية، والسعي لتحقيق مرضاة اللّه تعالى في كل أمر والتقرب إليه في كل مسعی عدالة بدرجة عالية كما هو عند قسم من المجتهدين تلزمه بالاستقامة على خط الإسلام بنحو لا يرتكب كبيرة أو صغيرة على شرط أن تكون هذه الاستقامة طبعا له وعادة(1).
وبتعبير آخر أن يكون على مرتبة من التقوى تمنعه عادة من مخالفة التكليف الشرعي ومن الوقوع في المعصية، وإن كانت صغيرة، بحيث لو غلبته نوازع النفس ودواعي الشيطان نادراً فوقع في المعصية لأسرع للتوبة وأناب اللّه تعال(2) ورجع إليه.
وبموجب هذا المبنى فإن العدالة المشترطة في المرجع تختلف عن العدالة المشترطة في إمام الجماعة، ذلك أن العدالة المشترطة في الشاهد أو إمام الجماعة مثلا تعني: الاستقامة في العمل، وتتحقق بترك المحرمات وفعل الواجبات(3) و يكفي في إحرازها حسن الظاهر(4). كأن يكون الشاهد أو إمام الجماعة مستقيما في سلوكه ظاهرا كونه يصلي ويصوم ويحج ولا يشرب الخمر ولا يزني وهكذا.
وقد يمكن اختبار شرط العدالة العالية ومدى توفرها في المتصدي للمرجعية من خلال تدقيق عدة قضايا أخلاقية وسلوكية ترتبط بطبيعة المرجعية ومهماتها من أمثال:
1 - مقدار حب هذا المرجع للدنيا وزهده فيها، فعن الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم، فإن كل محبّ يحوط ما أحبّ»، فإن من أهم ما يبتلى به المرجع من أمور خطيرة هو الامتحان بحب الرئاسة والزعامة والموقع.
وقانون الابتلاء والامتحان عام وشامل لا يفرق فيه زمان ومكان عن زمان ومكان آخر بالنسبة لبني الإنسان، وحتى الأنبياء (عَلَيهِم السَّلَامُ) تعرضوا للامتحان والابتلاء، والمرجع
ص: 170
يتعرض ايضا إلى أنواع خاصة من هذه الامتحانات والابتلاءات، وإحداها هي قضية حب الرئاسة وحب الشهرة، فلا بدّ أن يراقب الإنسان المتصدي والمرجع العام من خلال موقعه وبشكل دقيق هذا الأمر في نفسه ويرى مدى حبه لهذه الرئاسة ولهذه الشهرة ولهذا الموقع الخطير.
كما يجب على الأمة أن تراقب ذلك بدقة أيضا لتشخيص المرجع ذي المواصفات المطلوبة، وقد عشنا فترة طويلة عاشرنا فيها علماء وأفاضل كراما ومراجع عظاما كانوا يراقبون في أنفسهم هذا الجانب مراقبة شديدة ويتورعون عن كل ما يمت إلى هذا الحب بصلة.
2 - وأمثال : حسن اختيار الحاشية.
3- والحرص على بيت المال والانفاق على مصالح الأمة بطريقة عادلة بعيدة عن القضايا الذاتية والمصالح الشخصية، فقد جعل القرآن الكريم المال (فتنة)، ثم تعرض لدور الأموال في حركة المجتمع الإنساني سلبا في إفساده، وإيجابا في إصلاحه وتطوره وتزكيته.
4 - وأمثال الموقف المناسب الذي يتخذه المرجع من حكام الجور الذين أبتليت بهم الأمة، فمن خلال تاريخ أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وسيرة مراجعنا الصالحين العظام نلاحظ أنهم كانوا يقفون دائما في مواجهة الظالمين موقف الإنكار لهذا الظلم بدرجة تتناسب والظروف المحيطة بهم والأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة، إلّا ان (الرفض) كان أصلا ثابتا في مواقف أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) والمراجع.
5 - وأمثال: تقديم المرجع لمصالح الأمة على المصالح الخاصة له، فعندما يحدث التضاد والتزاحم بين مصالحه ومصالح الأمة، فهل يقدم المرجع مصالح الأمة وقضاياها
ص: 171
على مصالحه الخاصة وشؤونه الخاصة، أو یقدم مصالحه الخاصة على مصالح الأمة بحيث يرى المتصدي للمرجعية نفسه أنه أصبح هو الأمة كلها بمصالحها وشخصيتها وشؤونها.(1)
وهناك أمثلة عديدة على تقديم المرجع لمصالح الأمة على مصالحه الخاصة لا العكس، من ذلك مثلا ما حدث بعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري فقد برزت إلى الوجود مرجعية الشيخ محمد حسن الشيرازي المتوفى في (سنة 1312ه/ 1894م) ومرجعية الشيخ حبيب اللّه الرشتي المتوفى في السنة نفسها أيضا سنة، فكان الشيخ الرشتي يقول: ارجعوا في تقليدكم إلى المرجع الشيخ محمد حسن الشيرازي، ولا ترجعوالي، لأنه أهل لذلك.
وبالفعل قام الشيخ الرشتي بتثبيت مرجعية الشيخ الشيرازي الكبير في الجلسة التي عقدت في داره من قبل مجموعة من العلماء بخصوص هذا الأمر المهم.
ولا زلت أذكر بجلاء، وأنا داخل الصحن الحيدري الشريف، يوم انثنت الحشود المؤمنة التي غصّت بها مدينة النجف الأشرف أثناء تشييع جثمان المرجع الأعلى في حينه سماحة السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) المتوفى عام (1390 ه/ 1970م) زاحفة باتجاه نجله الكبير سماحة السيد يوسف الحكيم (قدّس سِرُّه) معلنة تقليدها له فأبت نفسه المتقية إجابة طلب الناس هذا.
يقول صاحب كتاب : (معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام) في ترجمة السيد يوسف الحكيم ما نصه: وانقادت له الزعامة والمرجعية بعد وفاة أبيه، غير أنه لورعه وزهده وتقواه لم يتقبلها وانصرف إلى مواصلة الجهاد العلمي وترك الدنيا وما فيها(2).
ص: 172
وأين هذا الموقف وأمثاله من مواقف مدعي الاجتهاد، بل مدعي المرجعية زورا، ممن ابتلينا بهم هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...؟
6 - ومنها : عدم التعصب القومي والمناطقي والمحلي وأمثالها من دواعي التعصب الأعمى المخالف لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين عملا بقوله تعالى في محكم كتابه المجيد: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْتَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ»(1) ولا ينا في ذلك الاعتزاز بالنسب أو القومية أو المنطقة أو البلدة أو الوطن أو ما شاكل لأن الاعتزاز غير التعصب الأعمى كما هو واضح.
وقد حارب مراجع الدين والمجتهدون العصبية والقومية والمناطقية بأفعالهم حينا وباقوالهم أحيانا واهتموا بإلغاء حالة الشعور بالامتياز أو التعصب للانتماءات القومية والإقليمية في أوساط الحوزة والتي كانت تنشأ أحيانا بسبب قوة الأوضاع الاقتصادية أو النفوذ الإداري أو العلمي والشعور بالاستعلاء والامتياز بسبب ذلك، أو الاحساس بالمظلومية والحرمان والدونية بسبب الاستضعاف وقلة الموارد وغير ذلك من الاسباب وهذه المشاعر بالاضافة إلى آثارها السلبية في العلاقات بين أطراف الحوزة وتماسكها كان لها آثار سلبية في نموها وتطوها العلمي والروحي من ذلك مثلا أن الإمام السيد محسن الحكيم المرجع الأعلى في حينه قد اهتم بشكل خاص بأبناء الحوزة من البلدان المستضعفة على مستوى تنمية العدد حتى أنه بلغ عدة أضعاف في بعض الجاليات عما كان قبله، وعلى مستوى رعايتهم المعنوية والمادية وبث روح الاعتماد على النفس والثقة بالمستقبل وعلى مستوى التحصيل العلمي لإيجاد حالة نسبية من التوازن الواقعي بين الجاليات الإسلامية في الحوزة إن هذا الجانب من العمل كان يحتاج من الإمام الحكيم أن يبذل جهودا استثنائية لتحطيم الحواجز النفسية والأطر الاجتماعية الحوزوية وتجاوز
ص: 173
بعض التقاليد في التعامل مع الحوزة أو بين أبنائها وقدم تضحيات كبيرة في هذا المجال من أجل الوصول إلى هذا الهدف، كما دافع الإمام الحكيم وإلى النفس الأخير عن بقاء حوزة النجف مفتوحة أمام جميع أقاليم العالم الإسلامي للاستفادة من ينابيعها الثرية ومدارسها العلمية الغنية ومنهجها في التربية وكانت الأوضاع السياسية تضغط بقوة من أجل أقلمة النجف(1) وانغلاقها على نفسها أو قومها ما أمكن.
ص: 174
يعرِّف سماحة المرجع الأعلى في حينه السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه) المقلد الأعلم بأنه: الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره(1).
ويضيف سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) إلى التعريف المتقدم الجملة التالية بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاويه أقوى من احتمالها في فتاوي غيره(2).
ويذهب قسم من المجتهدين إلى أن المراد بالأعلمية هنا أن يكون صاحبها أقوى ملكة من غيره في مجالات الاستنباط، لا الأوصلية إلى الواقع لعدم إمكان إحرازها في الغالب، وكون الفتاوى التي منشؤها الأخذ بالاحتياط تقتضي أن يكون صاحبها أوصل لا تكشف عن علم صاحبها الذي هو المناط في المرجعية والتقليد(3).
ثم أنه يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط، ولا يجوز الرجوع في ذلك إلى من لا خبرة له في ذلك(4).
وأهل الخبرة بالأعلمية كما يوضح سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) في جوابه عن سؤال وجهته اليه(5) هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم المطلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي ثلاثة أمور:
الأول : العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه علم الرجال وعلم
ص: 175
الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، وتمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحيانا بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
الثاني : فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك.
الثالث : استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول.
وطريق الاطلاع على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية هو المذاكرة معهم أو الرجوع إلى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه بحسب الغالب أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقا عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الاتصال السهلة والسريعة.
ومع ذلك كله فقد يختلف أهل الخبرة فيما بينهم في تشخيص المجتهد الاعلم رغم اجتماع شرائط الحجية في كلا الطرفين المختلفين من أهل الخبرة، عندها كما يجيب سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه)(1) عن سؤال وجهته اليه بهذا الخصوص بقوله : يتعين سقوط كلتا الشهادتين عن الحجية ورجوع الأمر إلى اشتباه الأعلم بين الأطراف الصالحة للتقليد.
وحينئذ مع تمامية بقية شروط التقليد في الكل وعمدتها الاجتهاد وقوة العدالة وشدة الورع إن تيسر للمكلف الاحتياط بالعمل بأحوط القولين فاللازم عليه ذلك
ص: 176
تحفظا على الحكم الشرعي ومع صعوبته عليه ولزوم الحرج منه، فرحمة اللّه تعالى بالمؤمنين وسهولة الشريعة الحقة، تقضيان بتنازل الشارع الأقدس عن الاحتياط الذي هو مقتضى الأصل الأولي عند اشتباه الحجج واكتفائه بتقليد أحد الأطراف مع تحري الأقرب فالأقرب مهما أمكن. وذلك يقتضي ترجيح مظنون الأعلمية. ومع تساوي الاحتمال في الأطراف يترجح الأورع، لأنه الأوثق في التحفظ على الحكم الشرعي بعد عدم ثبوت أعلمية غيره عليه.
ومع عدم المرجح المذكور فالمكلف مخير بين الأطراف المحتملة، فله تقليد أي طرف شاء واللازم على المكلف التثبت في جميع ذلك والتأكد منه ولو بالاستعانة بأهل التقوى والمعرفة من أجل استيضاح الرؤية بالمقدار المستطاع و «الإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»(1). و «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».(2)
وربما رأى البعض غرابة في اختلاف أهل الخبرة عند سؤالهم عن المجتهد الأعلم، بيد أن هذا الاختلاف في التشخيص أمر مألوف ومتعارف في كل العلوم والتخصصات نتيجة تفاوت وجهات نظر أهل الخبرة والتقييم في تحديد المجتهد الأعلم بسبب كون الأعلمية من الأمور الاجتهادية الحدسية التي من شأنها أن تختلف فيها الأنظار وتتباين وجهات النظر. ويتعين التعامل معها بموضوعية وانفتاح مع الاحترام المتبادل بعد كون الأطراف معنية بالحقيقة وهي في مقام أداء الأمانة والخروج عن العهدة، ولا يفترض في الإنسان أن يلزم الآخرين بقناعاته.
وقد يحسن أن نذكر مثالا عشناه كما يقول سماحة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه) فقد كان المرحوم آية اللّه الحجة الشيخ محمد طاهر آل راضي (قدّس سِرُّه)(3) مقتنعا بالتخيير بين المرجعين العظيمين السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) والشيخ محمد رضا آل ياسين (قدّس سِرُّه)(4)، وكان له جماعة يسترشدونه في خوزستان فأخبرهم بقناعته فاختاروا
ص: 177
السيد الحكيم (قدّس سِرُّه) وقلدوه، بينما اختار أهل الشيخ آل ياسين تثل فقلدوه وبقيت علاقته بجماعته وبالمرجعين العظيمين وبجماعتهما على أحسنها مع اطلاعهم على موقفه.
ومن قبل كان الإمام الحكيم (قدّس سِرُّه) يرشد للمرحوم الميرزا النائيني (قدّس سِرُّه) وأخوه الأكبر منه آية اللّه السيد محمود الحكيم (قدّس سِرُّه) يرشد للمرحوم المرجع المعظم الشيخ علي نجل الشيخ باقر الجواهري (قدّس سِرُّه) كل منهما حسب قناعته، من دون أن يؤثر ذلك في علاقتهما الحميمة ونظائر ذلك كثيرة(1).
بل وأكثر من ذلك فقد قصد أحد كبار التجار الشيخ آل ياسين في مجلس درسه العالي الذي لا يحضره إلّا صفوة من المجتهدين وكان يقيمه في داره، فقال التاجر الوجيه للشيخ : أريد أن أقلِّدك.
فقال آل یاسین عجیب!! رجل بمنتهى الوثاقة عند العلماء غير مقلِّد للآن!!.
قال: لا، أنا مقلِّد للسيد الحكيم (السيد محسن الحكيم) وأريد العدول عنه إلى تقليدك !!
فلما سمع ذلك الشيخ اصفرّ وجهه،واحمرّ، ونزع عمامته من على رأسه، وضرب بيده عليه قائلا : اللّه أكبر، السيد مجتهد مطلق عادل، وأنت تريد العدول عنه ؟ وتكلّم بكلمات الإشادة بالسيد الحكيم وأوجب على السائل البقاء على تقليده(2).
وقد يحسن بي أيضا أن أذكر مثالا عشته شخصيا، فقد حدثني مرة سماحة المرجع الحالي السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه) قبل ستة أشهر من تاريخ كتابتي لكتابي هذا، وهو في معرض حديثه عن حالة مشابهة تخصه قائلا : إنه ليوم الناس حيث هو مرجع مقلَّد لا يعرف ولا يريد أن يعرف مَن مِن المراجع يقلِّد أولاده الذين يعيشون معه في بيته وكذلك أخص الناس به من الأقربين فضلا عن الأبعدين، وهذا هو شأن المراجع الحقيقيين من
حاليين وسابقين.
ص: 178
أما طريقة انتخاب المرجع ومعرفة المرجع الأكثر تقليدا (المرجع الأعلى)، فقد درج الشيعة الإمامية على طريقة خاصة بهم في انتخاب مقلدهم أو مرجعهم الديني، وكذلك معرفة مرجعهم الديني الأعلى من بين المراجع العديدين المتصدين للإفتاء في تلك الفترة بما تتفرد به النجف عن غيرها من المراجع الدينية العليا في العالمين الإسلامي غير الإمامي أو المسيحي، حيث يكون انتخابه أو تحديده بصورة تلقائية متدرجة عبر الزمن، فمنذ أن تبدأ شهرة تضلّع أستاذ من أساتذة الحوزة بالانتشار والذيوع في أوساط الحوزة العلمية المنتجة له، تلك التي درس ودرّس فيها، وباحث وبحث، وناقش ونوقش، وأنه أصبح بعد سنوات جدّ واجتهاد وسهر ومكابدة مجتهدا بالمعنى الأخص وعالما متبحرا ومحققا في مجال تخصصه، يشهد له بذلك تلامذته وطلابه والمخالطون له من المشتغلين بالبحث والتدريس والمناظرة والتحري والاستقصاء، ويعرف أهل الخبرة من أهل هذا الفن والمتخصصين فيه اجتهاده من خلال نشره لبحوثه وكتبه وتأليفه ذات البعد العلمي الكاشف لبلوغه مرحلة الاجتهاد وأمثال ذلك، ثم قرر هذا المجتهد بعد ثبوت اجتهاده وفق الأصول المتبعة أن يتصدى للمرجعية، بأن مارس عملية الإفتاء في المسائل الشرعية الفرعية، وأجاب سائليه عن رأيه في المسائل التي يستفتونه بها ثم أوصل فتاويه إلى الناس كي يعملوا بها كما تقدم عندئذ يكون مرجعا دينيا.
إن الاهتمام بقرينة كون المرجع معترفا به في أوساط الحوزة العلمية بعلمائها ومدرسيها وفضلائها وطلابها بالاجماع أو بالرأي العام الغالب في مؤسسته العلمية المنتجة له أمر مهم لتمييز المجتهد الحقيقي من مدعي الاجتهاد زورا وبهتانا. وليست هذه القرينة حكرا على معرفة المجتهدين أو المراجع في مجال علوم الشريعة وحدها بل هي قرينة عامة على معرفة مستوى كل باحث في مجال اختصاصه العلمي إن أية درجة
ص: 179
علمية عالية لا يمكن القبول بها ما لم نرجع إلى المؤسسة التي تربى فيها فالأطباء مثلا لا يمكن القبول بادعائهم لمستوى عال من الطب ما لم يكن هناك اعتراف من قبل المؤسسات الطبية والجامعات العلمية التي تخرج الأطباء في هذا الوقت وبدون هذا الاعتراف لا يمكن قبول مثل هذا الطبيب بهذا المستوى العالي إن اعتراف هذه المؤسسة المختصة بهذا المرجع هو الضمان الذي يمكن أن نحرز من خلاله في المرجع هذه الدرجة العلمية ونسد الطريق بذلك على أدعياء المرجعية(1).
وفي حالات نادرة من تاريخ الحوزة العلمية النجفية ربما بقصد تحقيق المصلحة العامة أو من أجل تيسير أمر تشخيص المرجع الأعلم على المكلفين، تولى بعض المجتهدين المعاصرين يومها أمر التحقق من توفر الشروط المطلوبة في المجتهدين المتصدين ذلك الوقت من أجل اختيار ابرزهم كمرجع أعلى.
من ذلك مثلا أن لجأ الناس في الحالة الأولى إلى عالم محقق معروف ليعينهم على تحديد المجتهد الأعلم من بين العديد من المجتهدين المؤهلين لذلك كما حصل في سنة (1228ه / 1813م) حين أناطت الناس وعلماؤهم أمر تشخيص الأعلم إلى الشيخ المحقق القمي ( صاحب القوانين) فرشحه لهم فتبعوه.
وأقدم في الحالة الثانية أهل الخبرة والاختصاص ومن يرجع اليهم المكلفون بالسؤال عن المرجع الأعلم الذي يجب عليهم تقليده بعد وفاة المرجع الأعلى في عصرهم - وكان يومها سماحة الشيخ موسى آل كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه) المتوفى سنة (1241ه/ 1826م)- فرشح هؤلاء الخبراء وأهل الاختصاص سماحة الشيخ علي آل كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه) لتولي أمر المرجعية العليا بعد انتقال المرجع الأعلى حينها إلى جوار ربه الرحيم.
وأقدم في الحالة الثالثة المرجع الأعلى للتقليد في عصره سماحة الشيخ محمد حسن
ص: 180
النجفي المعروف بصاحب الجواهر المتوفى سنة (1266ه/1850م) على ترشيح سماحة الشيخ مرتضى الأنصاري (قدس سرهما) ليكون المرجع الأعلى للتقليد من بعده، كما سيأتي ذلك مفصلاً لاحقاً.
ومما يجدر ذكره أن هذا الترشيح غير ملزم للمكلفين(1)، ولكنه يسهل عليهم أمر تشخيص مقلدهم كثيرا باعتبار أن من رشحه للمرجعية هو في مقدمة أهل الخبرة الثقات الذين يرجع اليهم المكلف عادة لسؤالهم عن المجتهد الذي يريد السائل تقليده للخروج من عهدة التكليف وبخاصة بعد سعة مساحة انتشار أتباع مذهب أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) في أرجاء المعمورة وعدم معرفتهم بأهل الخبرة كي يسألوهم إضافة لأمور أخرى عديدة باتت واضحة لمن عاش في أوساط المكلفين البعيدين عن مراكز العلم وحوزاته وهو مع تحدید آلیات تنفيذه مفيد للطائفة في ظروف كظروفنا هذه وللمستقبل من دون أن يكون ذلك سنة إلزامية متبعة.
إن هذه القرينة العملية وامثاها هي التي تشهد للمتصدي لشؤون المرجعية بأنه مجتهد عادل ثقة مؤهل حسب شهادة أهل الاختصاص لتولي شؤون المرجعية أو المرجعية العليا، فإذا عرف الناس ترشيح كبار أهل الخبرة له باعتباره الأعلم، قلّدوه فأصبح مرجعا دينيا، ثم إذا بزّت شهرته عند أهل الخبرة شهرة المراجع الآخرين المعاصرين له وكثرت شهادتهم له بالأعلمية بما بر شهادات الآخرين بفارق معتد به، فزاد تبعا لها مقلدوه عن مقلدي غيره من المراجع المعاصرين بفارق ملحوظ عدّ من قبل الحوزات العلمية والمؤمنين مرجعا دينيا أعلى من دون النظر لجنسية المرشح ولا لمنطقته ولا لغير ذلك من أمثالها كما هو واضح.
أما من هم أهل الخبرة وكيف يستطيعون تمييز المرجع الأعلم من بين أقرانه العلماء الآخرين فسأضرب لذلك مثلا يلقي ضوءا على هذه العملية في مثلا يوجد عدد وافر
ص: 181
معروفون بالعلم والفضل، وهم بين مجتهد مطلق ومتجزي ومراهق وهؤلاء كلهم يشتركون في تمييز الأعلم من غير الأعلم ومن ثم يسمون (أهل التمييز)، ومعنى ذلك أنهم يستطيعون تمييز الأعلم من غير الأعلم فإن هؤلاء بعد ممارستهم للبارزين من العلماء بالحضور في دروسهم تارة وبمرافقتهم العلمية أخرى وبالمذاكرة معهم في المسائل المعقدة التي هي مطرح أنظار جهابذة العلماء ثالثة يتضح لهم المتفوق منهم بالإحاطة والاستقراء وإرجاع الفرع الفقهي لمبانيه وبإرجاع القاعدة الأصولية والفقهية إلى أسسها الرصينة، بل إرجاع كل دليل ظني إلى دليل قطعي، وبتنبهه لما خفي على غيره من السلف و المعاصرين، إذا كان ذلك كله شهدوا له بالأعلمية. ثم لا تكون المسألة الواحدة والمسألتان أو الباب الواحد من أبواب الفقه أو الأصول أو المسائل المدونة في الكتب مقياسا للتفوق بل المقياس التفوق فيها وفي غيرها من المسائل التي تخلق مع الزمن. فإذا كثرت ممارسة العلماء البارزين وظهور تفوقهم بالإحاطة وإتقان المباني وإرجاع كل دليل ظني إلى دليل قطعي مع التنبهات الرفيعة والالتفات للدقائق الخفية إذا كان ذلك كله نعتوا الشخص الذي هو كذلك بصفات ترفع مستواه عمّا عداه، وقالوا إنه أعلم(1).
هكذا هو حال اختيار المرجع الديني الشيعي والمرجع الأعلم فهو لا يعينه مسؤول في الجهاز التنفيذي في هذه الدولة أو تلك فيكون ساعتها مرجعا أو مرجعا أعلى كما هو العرف السائد في اختيار أو انتخاب أو تعيين رئيس الشؤون الدينية أو المفتي العام أو ما شابه ذلك في الأعم الأغلب من الدول العربية والإسلامية حيث يعينهم رئيس الجمهورية أو الملك أو رئيس الوزراء أو وزير الأوقاف أو شبهه، كما أن المرجع الشيعي لا يعينه ولا يصادق على تعيينه مجلس نواب أو مجلس شيوخ أو أشباههما كما هو الحال في العديد من الدول العربية أو الإسلامية الأخرى.
ص: 182
ويذهب بعض الباحثين في مقام تحديد تاريخ زمني لنشوء المصطلح إلى القول بأن مصطلح المقلد الأعلم والأعلمية ظهر للمرة الأولى لدى العاملي في معالم الأصول، لكن الأعلم عنده هو ذاك المتقدم في رواية الحديث وأقوال الأئمة، لكن عندما استقر الشيخ الأنصاري المتوفى سنة (1281ه/ 1864م) خلفا للشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر المتوفى سنة (1266ه/ 1850م) باعتباره الأعلم حيث كانت أعلميته مفهومة بمعناها الكامل الذي يجعله مرجعا للتقليد في أصول الدين و أصول الفقه كما هو تقليد المدرسة الأصولية، بل إن المرجع الشيخ مرتضى الأنصاري (قدّس سِرُّه) ادعى الاجماع على أن المجتهد المعتبر هو الأعلم في الأصول، وأوضح المرجع السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي المتوفى سنة (1838 ه/ 1920م) أواخر القرن التاسع عشر شروط الأعلمية كما قال بضرورة تقليد المجتهد الأعلم في الوقت بالإضافة لذلك أكد السيد اليزدي ضرورة التقليد من جانب المكلف للمجتهد الأعلم واستحالة معرفة أحكام الدين بدون التقليد(1).
ص: 183
ص: 184
ومما يلفت النظر في عملية اختيار المرجع الديني الشيعي حقا القدرة على تجاوز الحالة القومية أو العنصرية أو المناطقية في تشخيص المرجع أو المرجع الأعلم سواء أكان ذلك التجاوز على مستوى الطبقة العليا من المجتهدين وذوي الخبرة في التشخيص والفضلاء وأمثالهم أم على مستوى القاعدة المؤمنة المقلّدة، ما يدل على مستوى عال من الالتزام بالحدود الشرعية وفهم عميق وتطبيق دقيق لمفاهيم وقيم الإسلام الخالدة.
وقد مرّ علينا مثل هذه الحالة في الحديث عن شرط العدالة العالية ومدى توفرها في المتصدي للمرجعية من خلال تدقيق عدة قضايا أخلاقية وسلوكية ترتبط بطبيعة المرجعية ومهماتها كانت منها قضية تجاوز الحالة القومية والمناطقية والشلليّة وأشباهها.
ومن يستطلع تاريخ المرجعية يجد عشرات النماذج والأمثلة على هذه الرؤية في عملية الاختيار فقد ذاع اسم الشيخ محمد حسن النجفي مؤلف الموسوعة الفقهية (جواهر الكلام) في الأوساط الفارسية والتركية في إيران والقفقاز وأذربيجان وإيروان كما ذاع اسمه في الهند وهو فقيه عربي من العراق.
وتعاقب بعد ذلك فقهاء من العراق وإيران على مرجعية الشيعة فعم تقليدهم البلدين مثل مرجعية الفقيه الشيخ جعفر كاشف الغطاء من فقهاء العراق (العرب) الكبار الذي شاع تقليده في إيران في العصر القاجاري وسافر إلى إيران واستقبلته إيران
ص: 185
استقبالا حافلا ومرجعية السيد ميرزا حسن الشيرازي الذي شاع تقليده في العراق بصورة واسعة(1).
وفي عصرنا القريب يمكن أن أذكر وأذكر بسعة انتشار المرجعية العليا للفقيه العربي العراقي سماحة السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) المتوفى (سنة 1390 ه/ 1970م) والذي امتدت مرجعيته العليا حتى وفاته فغطت مدن العراق وإيران وأفغانستان والهند وباكستان وأفريقيا وأوربا وأمريكا وإستراليا ودول أمريكا اللاتينية وتجاوزتها إلى غيرها من دول العالم غير العربية، فضلا عن الدول العربية طبعا، ثم ما كان من انتشار وسعة المرجعية العليا اللاحقة لمرجعية السيد الحكيم (قدّس سِرُّه) وهي مرجعية سماحة السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي قتل المتوفى سنة (1423ه/ 2002م) والذي غطت مرجعيته وهو المرجع الإيراني مولدا، والنجفي مسكنا ومدفنا مدن العراق والدول العربية كلها فضلا عن الدول غير العربية المتقدم ذكرها فيما سبق.
وما لنا نذهب بعيدا وفي يوم الناس هذا تغطي المرجعية العامة للمرجع الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) مدن العراق وباقي الدول العربية الأخرى، فضلا عن الدول غير العربية في شرق العالم وغربه حتى عمت شهرته ومواقفه المشهودة عند المعنيين بها دول العالم كلها.
ولعل أوضح وأجمل شاهد على تجاوز الحالة القومية في التقليد هو ما تقدمه اليوم مرجعية النجف الأشرف، ففي النجف الأشرف اليوم أبرز مراجع التقليد أربعة هم: المرجع الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) وهو إيراني المولد نجفي النشأتين الحياتية والعلمية.
ثم المرجع الديني الكبير سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه) وهو عربي الأصل
ص: 186
عراقي المولد نجفي النشأتين الحياتية والعلمية.
وسماحة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض وهو أفغاني المولد، نجفي النشأتين الحياتية والعلمية.
وسماحة المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، وهو باكستاني المولد نجفي النشأتين الحياتية والعلمية كذلك.
ونتيجة لتوفر الشروط المتقدمة من اجتهاد وعدالة وشهادة وتصد للمرجعية وغيرها في أكثر من شخص واحد في زمن واحد، ولفتح باب الاجتهاد على مصراعيه في المذهب الجعفري، يتعدد في الغالب مراجع التقليد وتتنوع الاجتهادات والآراء، وهو ما يكسب علم الفقه و أصوله حيوية وغنى وعافية طالما حفزت طلاب الحقيقة على التجديد ومواكبة المتغيرات باستمرار.
ص: 187
ص: 188
تحملت المرجعية الدينية ونهضت ولا زالت تتحمل وتنهض بمهمات جسيمة ربما يمكن إجمالها بثلاث مهام كبرى هي :
استيعاب وإبلاغ الرسالات الإلهية وتلاوة آيات اللّه والمحافظة عليها وهداية الناس إلى الحق والهدى والصلاح والعقيدة السليمة وإخراجهم من الظلمات إلى النور.
التزكية والتطهير والتربية لهؤلاء الناس أفراد وجماعات في نفوسهم وسلوكهم وحياتهم الاجتماعية من خلال الإشراف والرقابة والشهادة على ممارسة الإنسان لدوره في الخلافة ومواكبة مسيرته تبشيرا وإنذارا ووعظ الناس في سلوكهم وعملهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحكم بين الناس بالقسط والعدل وتحقيق العزة والكرامة لهم ثم التدخل لمقاومة الانحراف واتخاذ التدابير الممكنة من أجل ذلك.
تعليم الناس الكتاب والحكمة وشرائع الإسلام وأحكامه والأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والسنن الإلهية التي تحكم حركة المجتمع الإنساني.
إن هذه المهام الأساسية تبقى ثابتة وإن كانت بعض مصاديقها وصورها تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن عصر إلى عصر فمصاديقها في يومنا الحالي غير مصاديقها فيما سبق وربما غير مصاديقها فيما يأتي وهكذا.
ص: 189
ورغم عظم المسؤولية الشرعية والحياتية وثقلها فإن المرجعية استطاعت بفضل اللّه ومنه أن تنجز التالي:
الحفاظ على الإسلام الأصيل في عقائده وقيمه ومفاهيمه ومنابعه الأصيلة وأحكام شريعته السمحاء من مصادره الأصيلة كتاب اللّه وعترة نبيه أهل بيته الطاهرين.
إبقاء باب الاجتهاد المضبوط مفتوحا كي تواصل هذه الحركة العلمية أكلها كل حين.
الحفاظ على وجود الجماعة الصالحة وحيويتها فقد كانت المرجعية ولا زالت تتحمل المسؤوليات العظام في ماضي الأمة وحاضرها. بل استطاعت بجهدها وجهادها تنمية هذه الجماعة الصالحة وتطويرها كما وكيفا وصولا بها إلى المرتبة العليا التي هي عليها اليوم.
تمكن المرجعية ومؤسساتها من المحافظة على معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة ثقافة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) بتفاصيلها العقيدية والتشريعية والأخلاقية والتأريخية وكل ما يمت اليها بصلة، ليس على المستوى النظري فحسب، بل وعلى المستوى التطبيقي والعملي حيث بقيت هذه الثقافة (ثقافة أهل البيت) أو ( الثقافة الشيعية) حية فاعلة في أوساط الأمة متجلية مظاهرها وتطبيقاتها على مدار السنة وفي أنحاء العالم كافة.(1)
قدرة المرجعية على تعبئة الأمة وقيادتها بحكمة وشجاعة خلال الفترات العصيبة التي مر بها العراق والأمة العربية والإسلامية في التاريخ الحديث وبخاصة ما كان منها منذ أوائل القرن العشرين والى يوم الناس هذا. وما لنا نذهب بعيدا ودور المرجعية العليا في النجف الأشرف الآن متمثلة بالمرجع الأعلى للطائفة سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) شاهد حي على ما قدمته المرجعية الدينية للعراق والشيعة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) فيه، وهو ما دوى صداه الإيجابي في أرجاء العالم كله شرقه وغربه، فضلا عن العراق والمنطقة بما لا يحتاج إلى زيادة إيضاح وبيان.
ص: 190
تختلف الظروف الحياتية والمعيشية والمزاجية بين أستاذ وآخر في كل معهد علمي أو جامعة أو مركز بحوث، بيد أن هناك قواسم مشتركة تفرضها طبيعة العمل العلمي أو العمل الاجتماعي العلمي بين علماء المسلمين في هذا المعهد العلمي أو ذاك أو بين هذه الحوزة العلمية أو تلك، لذا يمكن أن نجد في صورة برنامج يوم دراسي ل أستاذ في الحوزة العلمية أو مرجع من مراجع التقليد ما يمكن أن يقرب منهج عمل ودراسة وتدريس الأستاذ أو المرجع الديني في الحوزة العلمية في النجف الأشرف من ذهن القارئ الكريم.
ولهذا فسأدرج فيما يأتي برنامج يوم عمل دراسي لمرجع أستاذ من مراجع الحوزة العلمية توفي قبل أكثر من نصف قرن هو المرجع الديني سماحة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه) المتقدم ذكره والمتوفى في (سنة 1373ه/ 1954م)، وبرنامج يوم عمل دراسي لمرجعين معاصرين هما سماحة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، وسماحة المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام ظلهما) علّ ذلك يصلح لأن يكون أنموذجا تقريبيا مع فروق فردية لجهد ونشاط ومسؤوليات ومهام وواجبات ودراسة وتدريس واشتغال الأستاذ والمرجع في حوزة النجف الأشرف العلمية قبل أكثر من نصف قرن واليوم.
ص: 191
عرف عن أستاذ الحوزة العلمية الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء أنه كان يستيقظ يوميا وقت السحر ليصلي صلاة الليل،وليتهجد، حتى إذا بزغ الفجر وتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود منه أذّن لصلاة الصبح وأقام، ثم صلى وسبح تسبيح الزهراء وعقّب بما شاء له التعقيب أن يعقب، ليبدأ بعده بتلاوة معطرة من آيات اللّه البينات، حتى إذا طلعت الشمس تناول إفطاره المعدّ له ليعود بعده إلى الإجابة عن الأسئلة والكتابة والتأليف والمطالعة حتى الضحى، فإذا أزفت الساعة التاسعة صباحا خرج من بيته العامر إلى مقرّ إفتائه في مدرسته العلمية القائمة حتى يومنا هذا المصادف (1433 ه/ 2012م) في محلة العمارة بجوار مسجدهم الشهير مسجد آل كاشف والى جنب مقبرتهم الخاصة ذات القباب الزرق الجميلة، ليجلس الشيخ عند مكتبته العامرة يستقبل الوافدين ورجال الدين وذوي الحاجات ويفصل بين المتخاصمين ويوفق بين الأشتات ولا يغادر حتى أذان الظهر، ليستقبل الصلاة في الحرم الحيدري أو في داره حتى إذا انتهى من صلاته تناول طعام الغداء ونام بما يناهز الساعة حينا أو يترك النوم كي يستثمر هذه الساعة أحيانا بأن يخرج إلى حجرة مخصصة لشؤونه في مدرسته العلمية قد أعدها للتصنيف والتأليف والمطالعة والإجابة عن الأسئلة المختلفة التي يحملها اليه بريده باستمرار، وهي كثيرة، يبدو ذلك جلياً مما أورده هو عن نفسه في ترجمته التي كتبها بقلمه حيث قال: وكان البريد وغيره يوصل إلى مكتبتي سحابة عمري كتبا من الأقطار البعيدة والقريبة من العراق وخارجه تشتمل على أسئلة في مسائل عويصة ومشاكل غامضة في أصول الدين وفروعه وأسرار التشريع والحكمة في الأحكام، مضافا إلى الاستفتاء في الفروع الفقهية والقضايا العملية، فكان الجواب عنها يذهب مع السؤال، ولم نحتفظ إلّا بالنزر اليسير مما ذهب، وقد جمعنا من هذا النزر اليسير مجلداً كبيراً أسميناه
ص: 192
بدائرة المعارف العليا(1)، وهكذا يستمر عمل الشيخ المرجع دؤوبا لا يفتر إلى ما قبل الغروب بساعة عندها يخرج إلى مراجعيه وزائري ديوانه العامر فيقضي من حاجاتهم ما يمنحه له الوقت حتى غروب الشمس من فرصة ثم يذهب بعدها إلى الصحن الحيدري لأداء الصلاة جماعة مغربا وعشاء، وقد يزور الحرم العلوي بعدها، ومن ثم يذهب إلى درسه العالي (البحث الخارج) فيحاضر في الفقه ويعود إلى الدار أو المجلس أو الندوة، وبعدها ينكبّ على التحصيل العلمي حتى منتصف الليل، ليذوق بعدها غرارة من النوم حتى قبيل الفجر(2) وهكذا.
إن هذا العمل الدؤوب هو ما دعا الباحث جعفر الخليلي المعاصر للمرجع الشيخ والشاهد على برنامجه لأن يقول أكثر ما يعجبك من الشيخ هذا الجلد والصبر على العناء والاجهاد فهو بالاضافة إلى كثرة مراجعيه والوقوف على بابه وخروجه للصلاة بالناس ظهرا وعشاء وإلقائه سلسلة من البحوث في كل مساء فإن معدل ما يتلقى في اليوم ليتراوح بين خمسين أو ستين رسالة وقد يتجاوز المعدل في بعض المواسم المائة رسالة تأتيه من مختلف الأقطار الإسلامية وحتى من الأقطار الأفريقية والأمريكتين ومعظمها استفتاءات شرعية ومسائل اجتماعية وأدبية كان يقرؤها جميعا ويجيب عليها بنفسه وكان الكثير من تلك الأجوبة يكتبها على نفس الرسالة ويعيدها إلى صاحبها وكنت أرى بعض هذه الرسائل حين تتاح لي الفرصة، وكان بين تلك الرسائل والاستفتاءات رسائل من مختلف المذاهب والأديان وكثير منها ترد اليه من رجالات العلم والأدب المسيحيين المقيمين بلبنان والمهاجرين منهم وكان يجيب على كل منها في حدود مستواها ومضمونها(3).
عرف عن المرجع الديني الكبير سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله) من أنه
ص: 193
عادة ما يستيقظ لصلاة الفجر في أول وقتها حتى إذا أزف وقت الصلاة وحان موعد لقائه بربه الكريم نهض مشتاقا إلى فرحة لقائه حتى إذا فرغ من أداء صلاته الواجبة المحببه لديه نشط للتعقيب والدعاء وقراءة القرآن والذكر حتى مطلع الشمس - وقد كنت أعرف عنه هذا الالتزام وأشاهده يوميا ونحن محتجزون سوية في زنزانات مديرية الأمن العامة وسجن أبي غريب الخاص المغلق منذ أن اعتقل واعتقلت معه واعتقل رجال أسرتنا أيام النظام البائد لمدة تزيد عن (8) سنوات، وبالتحديد من يوم (10/ 5 / 1983 م - 6 / 6 / 1991م) - (1403 ه- 1411ه)، وقد ظل مواظبا على هذا النظام الحياتي إلى اليوم - فإذا بزغت الشمس هبّ (دام ظلّه) لمكتبته للمطالعة والكتابة والتأليف إلى أن يحين موعد الفطور فإذا تناوله عاد مسرعا إلى مكتبته متما كتابته من حيث انتهى مكبًا على تحضير درسه القادم حتى إذا أزفت الساعة التاسعة والنصف صباحا بدأ بإلقاء درسه على طلبته في خارج الفقه شارحا وموضحا ومناقشا ومشكلا على من سبقه ومجيبا من سأله، مبينا ما أشكل وموضحا لما غمض وهم بين مدون ما يقول أو مسجل ما يلفظ أو مصغ لما يحلل ويجيب، فإذا انتهى من إلقاء درس الفقه وأجاب عن أسئلة طلابه وإشكالاتهم عليه نهض لإلقاء درسه في خارج أصول الفقه حتى إذا أزفت الساعة الحادية عشرة تقريباً أنهى درسه الأصولي الموسع وأنهى بعده الإجابة عن أسئلة طلابه نهض ليجدد وضوءه ليخرج بعده إلى مكتبه العامر يستقبل الزائرين ويلتقي بالوفود الرسمية والشعبية التي اعتادت أن تؤم مكتبه العامر من داخل العراق وخارجه حتى أذان الظهر فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر قام لأداء صلاته وصلاة العصر يؤديهما في مكتبه جماعة مع من حضر من زوار مجلسه وقت الصلاة فإذا انتهى من صلاته وتعقيبه بما يتيسر له من محفوظاته من الأذكار والأدعية والذكر وقراءة والقرآن دخل بيته لتناول طعام الغداء وقد اعتاد متى ما وجد سفرة الغداء ممدودة والطعام لم
ص: 194
ينقل اليها بعد أن يستثمر هذه الفرصة فيشتغل بقراءة القرآن أو المطالعة وإن كانت لا تزيد المدة عن دقيقتين أو ثلاث حتى إذا وضع الأكل على المائدة وتناول منها ما يستعين به على أعماله من طعامه المعتاد ذهب سماحته للاستراحة فأخذ قسطا من النوم يفرضه عليه الجسد الناحل ليستيقظ بعده مستقبلاً وفوداً رسمية أو شخصية بموعد خاص مسبق غالباً ما يطلبه طالبه لأمر خاص به، فإذا انتهى من ذلك كله شرع بالإجابة أو مراجعة إجابات مكتبه عن استفتاءات المؤمنين حتى إذا فرغ منها دخل مكتبته ثانية من أجل المطالعة والتحضير والكتابة ماكثا فيها حتى يحين وقت غروب الشمس عندها قام ليجدد وضوءه استعدادا لأذان المغرب وصلاته ونافلتها وصلاة العشاء ونافلتها ثم يعود مرة أخرى لمكتبته للكتابة والمطالعة حتى يحين وقت العشاء عندها يتناول بسيط ما تهيأ له منه ثم يعود مجدداً لإكمال مطالعته وكتابته حتى إذا انتصف الليل وزاد قام ليؤدي صلاة الليل ويعقب بعدها ببعض الأدعية والأذكار ثم يخلد إلى الراحة ليستقبل يومه الجديد بما ودع به سابقه.
وكان من عادته إذا أرق أو طرقه طارق ما فحال بينه وبين النوم هرع من فراشه إلى مكتبته مشتغلاً بالكتابة والتحضير والمطالعة والتأليف فإذا هو مت عيناه ثانية انتزعته من کتابه وكتابته وعادت به إلى حيث مستقره الذي،فارقه كما كان من عادته أن يهتم بإبداء النصح لأولاده ومتابعة شؤونهم وغالبا ما يستثمر وقت تناول وجبة الطعام في الغداء أو في العشاء مستعرضاً معهم قصصاً وأحداثاً ذات مغاز تربوية وعلمية عديدة يحفظ ويستذكر منها الكثير الكثير بالأرقام حتى أدقها والتواريخ حتى أبعدها.
كما كان من عادته (دام ظلّه) في شهري رمضان ومحرم أن يتفرغ للكتابات في شؤون العقيدة والفكر.
هذا وقد اعتاد سماحته منذ نعومة أظفاره أن يكتب دروسه وتدريساته كلها، بما في
ص: 195
ذلك بحوثه التي يلقيها على طلبة الخارج في الفقه والأصول كليهما غير مكتف بتقريرات تلامذته عنها، وهي حالة جيدة جدا، وياليتها كانت شائعة لدى أساتذة البحث الخارج في حوزة النجف الأشرف. (ينظر الملحق السابع )
يمكننا أن نلخص برنامج يوم العمل للمرجع الشيخ الفياض بما يأتي:
أولاً: يبدأ العمل اليومي صباحاً بعد صلاة الصبح مباشرة التي تنتهي هي وأورادها بعد آذان الصبح بنصف ساعة وأكثر بقليل، بعدها مباشرة يمارس سماحته بعض الحركات الرياضية البسيطة لغرض المحافظة على لياقته البدنية وذلك لتعسر الخروج ومباشرته المشي في شوارع المدينة أو من البيت إلى الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) نظراً للظروف الأمنية غير المستقرة، وحدود هذه الممارسة الرياضية لا تتجاوز الساعة أو اقل بقليل.
بعدها في الساعة الخامسة صباحاً تقريباً يعكف سماحته في مكتبه لغرض القراءة والتأليف حتى الساعة الثامنة والنصف ويتخللها بعض الأحيان وبعد طلوع الشمس نومه خفيفة لا تزيد على النصف ساعة في أيام التعطيل عن الدرس فقط.
في الساعة الثامنة والنصف صباحاً يذهب سماحته إلى مكتبه لغرض البدء بالتدريس حيث يلقي درس الأصول أولا ثم درس الفقه على فضلاء وأساتذة الحوزة و الطلبة المتقدمين الذين قد يبلغ عددهم بحدود (300) شخص تقريباً يبدأ سماحته بالشروع بالدرس الأول (الأصول) بحدود الساعة الثامنة والنصف وخمسة دقائق وينتهي بحدود التاسعة وخمسة دقائق وهنا استراحة قصيرة لمدة خمسة دقائق ثم يبدأ الدرس الثاني (الفقه) وينتهي في الساعة التاسعة وخمس وثلاثون دقيقة، إن الدرس يبث عبر الانترنيت إلى كافة أنحاء العالم، بعد انتهاء درس الفقه يتوجه سماحته إلى
ص: 196
الطلبة للاستماع إلى مباحثاتهم والرد على إشكالاتهم الشرعية إن وجدت والاستماع إلى طروحاتهم وأسئلتهم سواء الشرعية أو ما يدور في الساحة العراقية والإسلامية والعالمية.
في حدود الساعة العاشرة صباحاً تنتهي فترة الدرس والمباحثات فيذهب سماحته إلى داره إلى الاستراحة ولتناول طعام الإفطار مع عائلته الكريمة.
يعود لمكتبه بحدود الساعة الحادية عشرة صباحاً أو اقل بقليل ثم يبدأ سماحته باستقبال المؤمنين من أبناء الطائفة وسائر المسلمين للرد على مسائلهم الشرعية والعقائدية وتنتهي فترة استقبال المؤمنين إلى حدود آذان الظهر عندها يبدأ سماحته بأداء الصلاة والعصر.
وبعد انتهاء صلاته وأوراده يتابع سماحته عادة شؤون وأعمال المكتب حيث يستدعي بعض الأخوان المشايخ من أعضاء المكتب لمناقشة بعض الأمور والأعمال المكتبية وكذلك تقدم له في فترات عمل المكتب الاستفتاءات الواردة إلى المكتب عبر الانترنيت من كافة أنحاء العالم ليرد سماحته عليها.
في تمام الساعة الثانية ظهراً يذهب سماحته إلى عائلته الكريمة لتناول الغذاء وللاجتماع مع أفراد أسرته وأولاده وأحفاده لينالوا قسطاً من توجيهاته وبركاته ورعايته الأبوية الكريمة.
وفي حدود الساعة الثالثة ظهراً يخلد سماحته إلى استراحة الظهيرة ليأخذ قسطاً من النوم ويطالع خلال هذه الفترة وقبل النوم الصحف المحلية والعالمية للاطلاع على ما يدور في البلد وفي العالم الإسلامي والعالم الخارجي.
في الساعة الرابعة والنصف تبدأ المرحلة الثانية من تحضير سماحته لبعض الدروس
ص: 197
ومراجعة البحث والاشتغال بتأليف كتابه القيم (محاضرات في علم الأصول) والذي أنهى منه لحد الآن احد عشر جزءاً وخلال هذه الفترة يبدأ سماحته أيضا باستقبال بعض المسئولين والعلماء والضيوف حسب مواعيد مقررة ومبرمجة.
وبعد غروب الشمس وبعد الانتهاء من صلاتي المغرب والعشاء وأورادهما تبدأ مرحلة ثانية من الرياضة المسائية البسيطة ولمدة نصف ساعة تقريباً.
وبعد الساعة الثامنة والنصف مساءاً يعود سماحته إلى مكتبه لغرض كتابة أجوبة الاستفتاءات الخطية الواردة إلى المكتب من كل أنحاء العالم الإسلامي، وكذلك على الدرس والتأليف حتى ساعة متأخرة من الليل، بعدها وبحدود الساعة الواحدة صباحاً يخلد سماحته إلى النوم لما لا يزيد على ثلاث ساعات ليستيقظ بعدها إلى حيث العبادة والصلاة (ينظر الملحق الثامن).
ص: 198
(1) الموسوعة الفقهية الميسرة. الشيخ محمد علي الأنصاري: 1 / 36
(2) الدكتور حامد حفني داود. مقدمة كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر. ط2 : 38 -48
(3) ينظر: الأصول العامة للفقه المقارن سابق: 552 وما بعدها.
(4) ينظر السمات المطلوبة للمجتهد الشيخ محمد إبراهيم الجناتي. بحث. مجلة الفكر الإسلامي. العدد 6 / 41-44 مترجما عن مجلة كيهان انديشه الفارسية العدد 52.
(5) ينظر المرجعية الصالحة. سابق: 81-86.
(6) موسوعة النجف الأشرف جامعة النجف الدينية 6 / 227 نقلا عن جامعة النجف للشيخ محمد تقي الفقيه.
(7) ماضي النجف وحاضرها: 1 / 280279.
(8) المصدر السابق : 1/ 380
(9) وسائل الشيعة إلى تحقيق مسائل الشريعة. الحر العاملي: 18 / 101. الحديث رقم: 9.
(10) هامش منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم. تعليق السيد محمد باقر الصدر 12/1. تعليقة رقم 25.
(11) منهاج الصالحين. السيد محمد سعيد الحكيم: 1/ 13.
(12) المسائل المنتخبة. السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي:9 مسألة 20.
ص: 199
(13) المصدر السابق : 137 مسألة 366 شرائط الإمامة.
(14) ينظر: المرجعية الصالحة. السيد محمد باقر الحكيم: 40 - 57.
(15) معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام. د. محمد هادي الأميني: 425/1.
(16) سورة الحجرات: 13
(17) الإمام الحكيم : السيرة الذاتية، الجانب العلمي، المرجعية الدينية، الحوزة العلمية. بقلم السيد محمد باقر الحكيم: 88-89.
(18) المسائل المنتخبة سابق: 8.
(19) منهاج الصالحين: 1 / 3.
(20) الأصول العامة للفقه المقارن سابق : 637.
(21) المسائل المنتخبة سابق: 8.
(22) الفقه للمغتربين. عبد الهادي الحكيم: 78 79.
(23) المرجعية الدينية / 2. سابق : 26 - 27.
(24) سورة القيامة : 14.
(25) سورة البقرة : 286.
(26) الشيخ محمد طاهر آل راضي (1322 – 1384) ه (1904 - 1964)م من مجتهدي الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومن أساتذة علم الكلام والشعر والأدب فيها من تأليفه (بداية الأصول في شرح كفاية الأصول) و (تعليقة على بعض مباحث المكاسب) إضافة إلى ديوان شعر رائع.
(27) الشيخ محمد رضا الشيخ عبد الحسين الشيخ باقر آل ياسين (1297 – 1370) ه ( 1880 - 1951) م من مراجع التقليد في النجف الأشرف ومن المقدسين
ص: 200
والأدباء والشعراء له من التأليف (بلغة الراغبين في فقه آل ياسين) و (حاشية العروة الوثقى ) و (دیوان شعر) جيد.
(28) المرجعية الدينية / 2 : 29 30.
(29) أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف. سابق : 22 - 23.
(30) المرجعية الصالحة. سابق : 84 – 85.
(31) ينظر: المرجعية الدينية. الحلقة الثانية. حوار صريح مع سماحة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم. سابق: 20
(32) موسوعة النجف الأشرف. جامعة النجف الدينية : 6 / 218 - 219 نقلا عن جامعة النجف للشيخ محمد تقي الفقيه.
(33) مرجعية التقليد. أحمد الكاظمي الموسوي منشور في دائرة المعارف الشيعية. سابق : 10 / 139 (بتصرف).
(34) التقليد والحالة القومية. الشيخ محمد مهدي الآصفي. منشور في دائرة المعارف الشيعية. سابق : 10 / 138.
(35) المرجعية الصالحة. سابق : 2016.(باختصار).
(36) من ترجمة الشيخ كاشف الغطاء بقلمه وهي الثانية وقد كتبها سنة 1371ه- 1952 م.العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية. سابق : 17 - 18.
(37) ينظر : أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف. الدكتور محمد حسين الصغير: 182 -193. ومقدمة كتاب جنة المأوى بقلم محمد علي القاضي الطباطبائي : 40.
(38) هكذا عرفتهم. جعفر الخليلي: 1 / 143 - 244.
ص: 201
ص: 202
ص: 203
ص: 204
في النجف الأشرف اليوم مراجع كبار سبق أن تصدوا للمرجعية بعد وفاة المرجع الأعلى في وقته سماحة السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي في (سنة 1412ه/ 1992 م) (قدّس سِرُّه)، فقلدهم المؤمنون على تفاوت في سعة تقليد كل مرجع منهم عن الآخر وضيقه، وهؤلاء المراجع الأربعة هم اصحاب السماحة كل من: المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، والمرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، والمرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض، والمرجع الشيخ بشير النجفي (دام ظلهم).
وسأتناول في هذا الفصل من خلال مباحث أربعة : السيرة الحياتية والعلمية لكل منهم، بادئا بالمبحث الأول المخصص لاستعراض موجز للسيرة الحياتية والعلمية للمرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه).
ص: 205
ص: 206
يحسن بي بادئ ذي بدء أن أتناول السيرة الذاتية للسيد المرجع، معرِّفا بولادته ونشأته العلمية، مسلطا الضوء على بعض من اهتماماته المعرفية الأخرى، ذاكرا أهم كتبه،ومصنفاته معرجا على مرجعيته ومنوِّها بمشاريعه وخدماته العامة للمؤمنين، وذلك في المطالب التالية:
ولد سماحة المرجع السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) في المشهد الرضوي الشريف في اليوم (التاسع من شهر ربيع الأول من عام 1349ه الموافق ليوم 1930/8/3م)، وسماه والده المقدس المرحوم السيد محمد باقر علياً، تيمناً باسم جده لأبيه. وكان العلامة الشيخ أغا بزرك الطهراني قد ترجم للسيد علي (قدّس سِرُّه) جد مرجعنا الحالي في القسم الرابع من كتابه الشهير طبقات أعلام الشيعة (ص 1432) حيث ذكر أنه كان في النجف الأشرف وأنه من تلامذة الحجة المؤسس المولى علي النهاوندي، وفي سامراء من تلامذة المجدد الشيرازي، ويعد سماحة المجتهد الشيخ محمد رضا آل ياسين (قدّس سِرُّه) من أبرز تلامذته.
وفي حدود سنة 1308 ه/ 1890م) عاد جد مرجعنا إلى مشهد الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) واستقر فيه، ثم انتقل مرجعنا الحالي السيد السيستاني (دام ظلّه) إلى الحوزة العلمية الدينية في
ص: 207
قم المقدسة على عهد المرجع السيد حسين البروجردي (قدّس سِرُّه)، وذلك في عام (1368ه/ 1949م)، وحضر بحوث علماء وفضلاء الحوزة آنذاك في الفقه والأصول، وقد أخذ الكثير من خبرته الفقهية وآرائه في علم الرجال والحديث من أستاذه المرجع السيد البروجردي (قدّس سِرُّه)، كما حضر درس الفقيه العالم الفاضل السيد الحجة الكوهكمري (قدّس سِرُّه) وبقية الأفاضل في حينه.
وكانت أسرته وهي من الأسر العلوية الحسينية تسكن في أصفهان على عهد السلاطين الصفويين، وقد عين جده الأعلى (السيد محمد) في منصب شيخ الإسلام في سيستان في زمن السلطان حسين الصفوي فانتقل إليها وسكنها هو وذريته من بعده.
وكان سماحة السيد دام ظلّه) بدأ وهو في الخامسة من عمره بتعلم القرآن الكريم، ثم دخل مدرسة دار التعليم الديني لتعلم القراءة والكتابة ونحوها، فتخرج من هذه المدرسة وقد تعلم أثناء ذلك فن الخط من أستاذه (الميرزا علي آقا ظالم)
وفي أوائل عام (1360 ه/ 1941م) بدأ السيد المترجم له بتوجيه من والده بقراءة مقدمات العلوم الحوزوية، فأتم قراءة جملة من الكتب: كشرح الألفية للسيوطي والمغني لابن هشام والمطوّل للتفتازاني ومقامات الحريري وشرح النظام على المرحوم الأديب النيشابوري وغيره من أساتذة الفن، ثم قرأ شرح اللمعة والقوانين على المرحوم السيد أحمد اليزدي المعروف ب(نهنگ)، وقرأ جملة السطوح العالية كالمكاسب والرسائل والكفاية على الشيخ هاشم القزويني، وقرأ جملة من الكتب الفلسفية كشرح منظومة السبزواري وشرح الإشراق والأسفار على المرحوم الآيسي، وقرأ شوارق الإلهام على المرحوم الشيخ مجتبى القزويني، وحضر في المعارف الإلهية دروس المرحوم الميرزا مهدي الأصفهاني. كما حضر بحوث الخارج للمرحوم الميرزا مهدي الاشتياني والمرحوم الميرزا هاشم القزويني (قدس سرهما).
ص: 208
وفي أواخر عام (1368 ه/ 1949م). هاجر إلى قم المقدسة لإكمال دراسته، فحضر عند العلمين الشهيرين السيد حسين الطباطبائي البروجردي والسيد محمد الحجة الكوهكمري، وكان حضوره عند الأول في الفقه والأصول، وعند الثاني في الفقه فقط. وفي أوائل عام (1371ه/ 1952م) هاجر من مدينة قم إلى النجف الأشرف، فوصل كربلاء المقدسة في ذكرى أربعين الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ثم نزل النجف فسكن مدرسة البخارائي العلمية، وحضر بحوث العلمين الشهيرين السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي والشيخ حسين الحلي (قدس سرهما) في الفقه والأصول، ولازمهما مدة طويلة، وحضر خلال ذلك أيضاً بحوث بعض الأعلام الآخرين منهم الإمام السيد محسن الحكيم والعلم السيد محمود الشاهرودي (قدس سرهما).
وفي أواخر عام (1380 ه/ 1961م)، عزم على السفر إلى موطنه مشهد الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وكان يحتمل استقراره فيه فكتب له أستاذه الإمام الخوئي وأستاذه الشيخ الحلي (قدس سر هما) شهادتين ببلوغه درجة الاجتهاد، كما كتب شيخ محدثي عصره الشيخ أغا بزرك الطهراني صاحب الذريعة شهادة أخرى يطري فيها على مهارته في علمي الحديث والرجال.
وعندما رجع إلى النجف الأشرف في أوائل عام (1381ه/ 1962م) اشتغل سيدنا المرجع بإلقاء محاضراته في (البحث الخارج) في الفقه على ضوء مكاسب الشيخ مرتضى الأنصاري (قدّس سِرُّه)، وأعقبه بشرح كتاب العروة الوثقى للسيد كاظم الطباطبائي اليزدي (قدّس سِرُّه)، فتم له من ذلك شرح كتاب الطهارة وأكثر فروع كتاب الصلاة وبعض كتاب الخمس. كما ابتدأ بإلقاء محاضرات (البحث الخارج) في الأُصول في شهر شعبان المعظم عام (1384 ه/ 1965م) حيث أكمل دورته الثالثة منها في شعبان المعظم(سنة 1411ه/ 1991م)، وقد سجل محاضراته الفقهية والأصولية غير واحد
ص: 209
من تلامذته.
للسيد السيستاني دام ظله كتب ورسائل عديدة أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الكتب والرسائل التالية:
شرح كتاب العروة الوثقى، وكتاب في القضاء، وكتاب في البيع والخيارات، وشرح مشيخة التهذيبين، ورسالة في اللباس المشكوك فيه، ورسالة في قاعدة اليد، ورسالة في صلاة المسافر، ورسالة في قاعدة التجاوز والفراغ، ورسالة في القبلة، ورسالة في التقية، و رسالة في قاعدة الإلزام و رسالة في الاجتهاد والتقليد، ورسالة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ورسالة في الربا، ورسالة في حجية مراسيل ابن أبي عمير، و نقد رسالة تصحيح الأسانيد للأردبيلي، و منهاج الصالحين في ثلاثة أجزاء، و المسائل المنتخبة، و مناسك الحج، وملاحق مناسك الحج، إضافة إلى أبحاثه وتقريراته في الأصول وغيرها.
أما منهجه البحثي في علم الفقه فيمكن أن نلمح فيه عدة أمور، منها المقارنة بين فقه الشيعة وفقه غيرهم من أتباع المذاهب الإسلامية الأُخرى، فإن الإطلاع على الفكر الفقهي السني المعاصر لزمان النص، كالاطلاع على (موطأ مالك) مثلا و (خراج أبي يوسف) وأمثالها، يوضح أمامنا مقاصد الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) في زمن النص، ومما يدل على مدى اهتمامه بكتب حديث وفقه وأصول المذاهب الإسلامية الأخرى وإحاطته بهما ما ورد في بعض بحوثه من استعراض ومناقشة لآراء فقهاء من مدارس مختلفة، ناهجا نهج المقارنة بين المذاهب الإسلامية المختلفة في ذلك.
وتجد في محاضراته المطبوعة في (قاعدة لا ضرر ولا ضرار) أسماء كتب مثل سنن ابن ماجة، وكنز العمال، وسنن الدارقطني، ونصب الراية والمستدرك على الصحيحين،
ص: 210
وسنن البيهقي، ومجمع الزوائد، والنهاية في غريب الحديث، وفتح الباري، والأم، و مسند أحمد بن حنبل، وموطأ مالك، وتهذيب التهذيب، وتحفة الأشراف، وجمع الجوامع، وبدائع الصنايع، والمبسوط، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومنتقى الأخبار ونيل الأوطار، والبحر الزخار من كتب المذهب الزيدي، ودعائم الإسلام من كتب الإسماعيلية وغيرها(1).
وقد حدثني الشيخ حسين الأميني من أنه صادف أن زار قبل حوالي خمسين (سنة من الآن) مرقد الإمامين الكاظمين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) مرة بصحبة سماحة السيد (دام ظلّه) بعد مجيئه من إيران، وسماحة الشيخ عبد اللّه البروجردي وكانوا يومها شبابا، فمروا في طريقهم على كلية الشريعة في منطقة الأعظمية ببغداد، فرغب السيد المترجم له بزيارة المعهد والاطلاع على مناهجه وطرق التدريس فيه وإجراء حوار مع أساتذته، فكان له ما أراد حيث دخل ثلاثتهم المعهد بزيهم الديني المعروف عند الشيعة الإمامية، فتوجهت الأنظار اليهم من قبل الأساتذة والطلاب بسبب عدم إلفتهم دخول ضيوف معممين من إخوانهم الشيعة عليهم. وبعد جلوسهم وتبادل كلمات الترحيب المعتادة في مثل هذه المناسبة دار الحديث بينهم حول الكتب الدراسية المعتمدة والمناهج، فكان السيد (دام ظلّه) يحاورهم محاورة المطلع المحيط بكتبهم وتأليفهم وآراء علمائهم واختلافاتهم في الأصول والفروع وما إلى ذلك، مما أثار إعجابهم بسعة اطلاعه على تصانيف فقهائهم وإحاطته بمبانيهم الأصولية والرجالية ومداركهم ومستنداتهم العلمية.
وأذكر أني حضرت مرة لقاءا جرى بينه (دام ظلّه) ووالدي (قدّس سِرُّه)، أشعرني فيه حديثه عن كتاب سيدي الوالد (الأصول العامة للفقه المقارن) مدى اهتمامه به وبمنهج المقارنة بين المذاهب الإسلامية، فقد سأل (دام ظلّه) يومها والدي (قدّس سِرُّه) عن موسوعته في الفقه المقارن التي كان خطط لإصدارها فيما يربو على عشرين مجلدا، وعن موعد صدور كتابه الثاني منها
ص: 211
بعد الأصول العامة، وهو كتاب (القواعد العامة في الفقه المقارن) فوعده والدي خيرا.
ومن منهج سيدنا المرجع (دام ظلّه) كذلك الاستفادة من علم القانون في بعض المواضع الفقهية، كمراجعته للقانون العراقي والمصري والفرنسي عند بحثه في كتاب البيع والخيارات، وقد حدثني بعض طلابه في البحث الخارج أنه كان يأتي أحيانا إلى الدرس ومعه كتاب (الوسيط في القانون المدني) للدكتور عبد الرزاق السنهوري، للاستفادة منه قدر الإمكان عند الخوض في موضوعات ترتبط بمحتواه. ولكون هذه البحوث القانونية تلقي الضوء على بعض المرتكزات العرفية ففي كتاب (قاعدة لا ضرر ولا ضرار) وهو من تقريراته تجد مراجع ككتاب: (مصادر الحق في الفقه الإسلامي) و(الوسيط في شرح القانون المدني)، وكلاهما للدكتور عبد الرزاق السنهوري وهكذا غيرهما(1).
ومن منهجيته في البحث الفقهي أيضا، نظرته الاجتماعية للنص الشرعي والسعي للإحاطة بأجوائه وظروفه ومناخه وملابساته التي تؤثر على دلالته، فقد ورد عن النبي الكريم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) مثلا أنه حرّم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر، فالفهم الحرفي يقول بالحرمة والكراهة، والفهم الاجتماعي يرى أن النص ناظر إلى ظرف الحرب مع اليهود في خيبر، والحرب تحتاج لنقل السلاح والمؤنة، ولم تكن هناك وسائل نقل الأ الدواب ومنها الحمير.
فالنهي في الواقع نهي إداري لمصلحة موضوعية اقتضتها الظروف آنذاك، ولا يستفاد منه تشريع الحرمة ولا الكراهة.
أما منهجه البحثي في علم الأصول فيختلف عن منهجية بعض من أساتذة الحوزة وأرباب البحث الخارج في الأصول، فهو يرى كما يذهب تلميذه السيد منير الخباز في تقرير لمحاضرات السيد المرجع في علم الأصول أسماه (الرافد في علم الأصول)
ص: 212
إلى أن الفترة التي نعيشها الآن بمقتضى العوامل الاقتصادية والسياسية تمثل الصراع الحاد بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى على مختلف الأصعدة، فلا بد من تطوير علم الأصول وصياغته بالمستوى المطلوب للوضع الحضاري المعاش، وقد ركزنا في بحوثنا على بعض الشذرات الفكرية التي تلتقي مع حركة التطوير لعلم الأصول من خلال الاستفادة من العلوم المختلفة قديمها وحديثها، كالفلسفة وعلم القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع، ومن خلال محاولة التجديد على مستوى المنهجية وعلى مستوى النظريات الكبروية(1) ففي مجال الفلسفة مثلاً رجع في بحوثه الأصولية إلى نظریات فلسفية عديدة ليرتب عليها بعض أفكاره الأصولية، كرجوعه إلى نظرية التكثر الادراكي الفلسفية ليرتب عليها مبناه في الوجود الرابط من أنه مجرد عمل إبداعي ذهني مرتبط بهذه النظرية، وكرجوعه إلى نظرية وحدة الوجود الفلسفية وهي من النظريات التي أولاها اهتماما خاصا في بحوثه ورتب عليها بعض مبانيه الأصولية.
وفي مجال علم المنطق اعتمد على دليل حساب الاحتمالات ورتب عليه ما ذهب أليه من رأي في تحليل مفهوم الشبهة المحصورة وغير المحصورة، وفي مجال علم الاجتماع نراه يرجع في بعض بحوثه الأصولية إلى هذا العلم لينتهي من خلاله إلى التفريق بين العادات والأعراف والتقاليد وليحدد ألمناشئ النفسية والاجتماعية لبناء العقلاء وارتكازاتهم. وفي بحثه حول مدلول صيغة الأمر ومادته يطرح نظرية بعض علماء الاجتماع من أن تقسيم الطلب لأمر والتماس وسؤال نتيجة تدخل الطالب في حقيقة طلبه من كونه عاليا أو مساويا، معتبرا هذه النظرة من رواسب الثقافات السالفة التي تتحدث اللغة الطبقية لا اللغة القانونية المبنية على المصالح العامة.
وفي المجال الأدبي نراه يستعين ببعض النظريات الأدبية في تحليل المفاهيم الأصولية، كاستعانته بالتورية في مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، كما نراه حين يتحدث عن
ص: 213
حجية قول اللغوي يبحث في تاريخ تدوين اللغة وطرق تدوينها وتاريخ علمائها ليصل إلى أن من عوامل عدم الاعتماد على قول اللغويين هو أن اللغويين يتأثرون بمذاهبهم الفكرية في تفسيراتهم اللغوية، فينعكس اتجاهه المذهبي في تفسيره وشرحه للمفردات اللغوية فلا يكون كلامه تعبيرا عن الفهم العربي الصافي(1) وهكذا.
ويمكنني الإشارة إلى خصائص أخرى في منهجه الأصولي بإيجاز. فمن ذلك انه اقترح منهجا في تصنيف علم الأصول وطريقة تبويبه تخالف المنهج السائد المتداول عند الأصوليين سواء القدماء القائلين بالتقسيم الرباعي منهم أم الأحدث طبقة كالشيخ الأنصاري الذي قال بالتقسيم الثلاثي، مختارا منهجا مختلفا يدخل إليه من مسلكين كلاهما يوصلانه لغرضه. فإما أن يدور منهجه المقترح مدار الحجة المثبتة للحكم الشرعي، وحينئذ يصح أن يصنف علم الأصول إلى أقسام ثلاثة. وإما أن يدور البحث فيه حول محور الاعتبار وشؤونه وتفصيلاته وحينئذ يبحث علم الأصول في خمسة عشر بحثا ولا مجال لاستعراض المسلكين في هذه العجالة.
ومن الطريف أنه يختتم بحثه حول منهجة علم الأصول المقترحة بما يوسعها لغير الأصول من العلوم الأخرى، معتقدا بأنها مفيدة في المجالات القانونية أيضا كالقضاء والمحاماة وسائر البحوث الحقوقية الأخرى، مما يستشف منه اطلاعه على خصوصيات البحوث القانونية بحيث يقترح منهجا لها مختلفا عن المناهج السائدة في أبحاثها.
ومن خصائص منهجه الأخرى بإيجاز أنه يبدأ بحثه الأصولي بالتحدث عن تاريخ البحث الذي ينوي الدخول فيه ومعرفة جذوره والإحاطة بها قبل الخوض فيه، ففي بحث التعادل والتراجيح مثلا، يذهب إلى أن قضية اختلاف الأحاديث فرضتها الصراعات الفكرية العقائدية آنذاك والظروف السياسية التي أحاطت بالأئمة، مما ينبغي الإحاطة بها بعناية قبل استكناه النص واستنطاقه مركزا على الروابط بين الفكر
ص: 214
الحوزوي والثقافات والمعارف الأخرى معاصرة وغير معاصرة. فتراه في بحث المشتق يتحدث عن الزمان نظرة فلسفية حديثة قوامها انتزاع الزمان من المكان، كما تراه يستشهد أحيانا بأقوال المفكرين والفلاسفة قدماء ومحدثين، فمن المفكرين والفلاسفة القدماء تجد أسماء تتكرر لأكثر من مرة من أمثال الشيخ الرئيس ابن سينا والمحقق الطوسي والسبزواري والقطب الرازي والملا اسماعيل والقاضي عبد الجبار والشافعي والباقلاني والشوكاني وأبي هاشم وبالمفكر الفرنسي (روسو) وغيرهم، موليا الاهتمام بالمباحث الأصولية المرتبطة بالفقه أهمية خاصة، باحثا الفقه الخلافي والفقه المذهبي عند الفريقين واعتمادهما معا على علم الأصول، مميزاً في بحثه عن الفقه الخلافي عند الشيعة بين التشيع الثقافي والتشيع السياسي، مقتطعا من مقدمة ابن خلدون أكثر من نص للتدليل على ما يقول به وينتهي إليه مركزا على جدوى النظرة الاجتماعية للنص، ذاهبا إلى أن الفقيه لا يكون فقيهاً حتى تتوفر لديه خبرة وافية بكلام العرب وخطبهم وأشعارهم ومجازاتهم، كي يكون قادراً على تشخيص ظهور النص تشخيصاً موضوعياً لا ذاتياً، وأن يكون على اطلاع تام بكتب اللغة وأحوال مؤلفيها ومناهج الكتابة فيها، فإن ذلك دخيل في الاعتماد على قول اللغوي أو عدم الاعتماد عليه، متبنيا ما ذهب إليه علماء الاجتماع من أن اللغة ظاهرة حية خاضعة للتطور والتبدل كسائر الظواهر الاجتماعية ذاهبا إلى ما ذهب إليه علماء النفس من أن طريقة التفكير ترتبط ارتباطا وثيقا باللغة المستخدمة عند التفكير فإن اللغات العالمية لا تختلف اختلافا لفظيا فقط بل ان كل لغة تتضمن بين ثناياها طريقة معينة للتفكير والتحليل(1)، قائلا بضرورة استيعاب أحاديث أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وكتبها التي احتوتها ومؤلفيها ومدى دقتهم في النقل وضبطهم وتثبتهم في نقل ما ينقلون مع التعرف على مناهجهم التي اعتمدوها في تأليفهم وكتبهم واختيار أحاديثهم وحال رواتها بالتفصيل، مركّزا على علم الرجال
ص: 215
تركيزا خاصا من اجل تحصيل الوثوق الموضوعي بصلاحية النص للاعتماد عليه في مقام الاستنباط، عارضا فكر مدرسة خراسان ومدرسة قم ومدرسة النجف الأشرف الأصولية العميقة، منتهيا من ذلك كله إلى رأي مختار بعد بذل الوسع واستنفاد الجهد في البحث والتحليل والمناقشة.
للسيد السيستاني اهتمامات معرفية متنوعة تنمّ عنها بعض الشواهد التي أذكرها هنا.
من ذلك ما حدثني به دام ظلّه) أثناء تشرفي بلقائه في أواخر ربيع الثاني من(سنة 1424ه/ 2003م) عن رأيه بإجراء انتخابات عامة لاختيار مجلس دستوري يكلف بكتابة مسودة الدستور العراقي الجديد وإقراره من قبل المجلس المنتخب أولاً، ثم بعد ذلك يجري التصويت على المسودة المقرة من قبل الشعب في استفتاء عام ثان لإقراره بشكله نهائي، معتبرا ذلك أفضل الطرق القانونية لوضع الدستور وأكثرها تمتعا بالشرعية، وهو ما تذهب إليه الغالبية من فقهاء الدستور، ما يدل على سعة اطلاع بآليات وضع الدساتير وفقهها. وقد حدثني ولده السيد محمد رضا بأنه (دام ظلّه) بدأ بمراجعة بعض الكتب في فقه القانون الدستوري، وقراءة دساتير بعض الدول للاطلاع عليها في الظرف الراهن الذي بدأ الإعداد فيه لوضع دستور للعراق كي يكون بأجواء العملية الدستورية القادمة في العراق الجديد.
كما حدثني (دام ظلّه) في معرض أجابته عما عرضته عليه من أهمية إطلاع المؤمنين على ما يتم من تواصل دائم بين مراجع التقليد في النجف الأشرف في هذا الظرف الاستثنائي الخطير في حياة العراق والعراقيين من أنه على اطلاع تفصيلي بتاريخ علاقة مراجع
ص: 216
النجف الأشرف ببعضهم منذ عهد الشيخ الأنصاري بالخصوص والى الآن، وأنه لم يقرأ أو يشهد طوال هذه المدة فترة مرّ فيها التعاون والتشاور بينهم بأحسن مما هو عليه الآن، مما يكشف عن مدى أحاطته بتاريخ المرجعية والمراجع في العراق. ثم راح يسردلي في حديث طويل تفاصيل ما هو قائم الآن بين المراجع وممثليهم من لقاءات واتصالات ومشاورات مباشرة مرة وغير مباشرة، وكيف أنه عزم على أن لا يبرم أمراً ذا بال إلا بعد أن يتباحث معهم بشأنه ويستأنس بآرائهم فيه.
وللسيد (دام ظلّه) اهتمام خاص بمتابعة ما يجد من نظريات ومعارف تمت بصلة ولو بعيدة بموضوع اشتغاله ونتيجة لولعه بالقراءة ولإدراكه أهمية ما يجدّ من طروحات وأفكار، فهو يتابع ما يصدر من كتب وما ينشر أحيانا في المجلات من آراء وبحوث، موليا علم التاريخ وفلسفته، وحياة وحضارة الشعوب والشخصيات والسياسات والأطروحات الفكرية عناية خاصة. وقد نقل لي أخي السيد علاء الدين أنه تشرف بزيارة سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) مرة فذكر له - رغم كثرة مشاغل المرجعية العامة وابتلاءاتها - أنه قرأ كتاب سيدي الوالد (قدّس سِرُّه) الموسوم: (عبد اللّه بن عباس: شخصيته وآثاره)، واستفاد منه كثيرا.
كما أنه (دام ظلّه) - يضيف أخي - تابع ما كان نشره السيد الوالد (قدّس سِرُّه) من كتب وأبحاث و دراسات ومقالات بما في ذلك ما اعتاد نشره في الدوريات والمجلات والنشريات أولاً بأول. ويشهد لذلك ما نقله بعض تلامذته عنه من أنه (دام ظلّه) كان في الفترة التي درسنا عنده يتابع أكثر الاصدارات والكتب الجديدة والنظريات المعاصرة في مختلف العلوم والحقول، وكنت أراه يشتري بعضها أو يستعير بعضها ويقرؤها ويردها لاصحابها، وكان يستفيد من مطالعاته العامة في بحوثه الفقهية والأصولية ويردد المنطق القراني «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُولُواً
ص: 217
الْأَلْبَابِ(1) وكان السيد المرجع أحيانا ينتقد تلك الأفكار أو ينبه على خطورة بعض الكتابات على الإسلام والمسلمين.
و للسيد (دام ظلّه) مكتبة خاصة كبيرة ومتنوعة تضم صنوف المعرفة المختلفة. وقد حدثنى سماحته أنه قرأ الكثير من كتب كبار مفكري الماركسية وما صنفه الشيوعيون وغيرهم عن الشيوعية ابان المدّ الشيوعي في العراق بعد ثورة (1958م / 1377ه) للاطلاع عليها ومناقشتها ودفع شبهاتها بما زاد عن العشرات. وأنه يحرص على متابعة ما ينشر من جديد الكتب والطروحات عن الإسلام والمسلمين وبخاصة ما ينشره ويدعو إليه بعض الأكاديميين المسلمين الجدد في الغرب.
وله في ذلك آراء ومناقشات لا مجال للحديث عنها في هذه العجالة. كما أنه يتمتع بذائقة فنية تهتز للشعر(2) وحافظة تختزن بعضا من نماذجه الجميلة التي قد يستشهد بأبيات منها خلال حديثه مع زائريه وضيوفه أحيانا.
في يوم (29 ربيع الثاني عام 1409ه الموافق ليوم 8 /12 / 1988م) ألمت بأستاذه المرجع الأعلى في عصره السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) وعكة صحية، فطلب منه أن يقيم صلاة الجماعة مكانه في جامع الخضراء، فلم يوافق على ذلك في البداية، فألح عليه في الطلب، وقال له: (لو كنت احكم كما كان يفعل ذلك المرحوم الحاج آقا حسين القمي تل لحكمت عليكم بلزوم القبول)، فاستمهله بضعة أيام ثم استجاب لطلبه، وأمّ المصلين ابتداء من يوم الجمعة 5 جمادى الأولى (1409 ه/ 1989م) إلى الجمعة الأخيرة من شهر ذي الحجة من عام 1414ه/ 1994م)، حيث أغلق الجامع، وقد تعرض سماحته في تلك الفترة للعديد من المحن والابتلاءات كما سيأتي.
ص: 218
وبعد وفاة السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) قتل كان سماحة سيدنا (دام ظلّه) من الستة المشيعين لجنازته ليلاً، وهو الذي صلى على جثمانه الطاهر، ونتيجة لسد الفراغ الحاصل بوفاة المرجع الأعلى وحرصا منه على الأمة المعذبة، فقد تصدى بعدها للتقليد وشؤون المرجعية وزعامة الحوزة العلمية، فقام بإرسال الإجازات، وتوزيع الحقوق، والتدريس على منبر الإمام الخوئي (قدّس سِرُّه) في مسجد الخضراء بالنجف الأشرف وغير ذلك مما يقتضيه تحمل هذا العبء الكبير من مهام ومسؤوليات.
للسيد السيستاني (دام ظلّه) مشاريع عديدة في مناطق وأماكن مختلفة في العالم من أمثال المجمعات السكنية لطلاب الحوزات العلمية، ومراكز إغاثة، ومستشفى ومستوصفات طبية، ومراكز علمية، ومؤسسات للنشر والطباعة والترجمة والتبليغ، ومواقع على الانترنيت وفروع ومكاتب في العديد من دول العالم لتقديم الخدمات الإسلامية للمؤمنين ودفع الشبهات عندهم.
كما ويهتم سماحته بشكل خاص بقضاء حوائج المؤمنين ومساعدتهم في البلدان المنكوبة باقتصاد سيئ كما في العراق وغيره وله وكلاء منتشرون في البلدان المختلفة في شرق الأرض وغربها لإيصال صوت المرجعية وخدماتها للمؤمنين مما لا يسع المجال لاستعراضها في هذا المختصر
لاقى سماحة السيد (دام ظله) من عنت النظام المقبور الشيء الكثير، ففي حملات التسفير البغيضة لعلماء وأساتذة وطلاب الحوزات العلمية التي أشرت لبعضها فيما سبق بإيجاز، سفِّر العديد من طلابه وتلامذته وحضار مجالس بحثه، وكاد أن يسفَّر مرات عدة لولا
ص: 219
عناية اللّه عز وجل ورعايته،له وعلى الرغم من ضراوة الحال وقسوته على العراقيين أيام الحرب العراقية الإيرانية الظالمة فضلا عن غيرهم فقد أصر سماحته على البقاء في حوزة النجف الأشرف أستاذا ومربيا وفقيها مستقل الرأي فيما يتبناه إيمانا منه بلزوم استمرار المسار الحوزوي المستقل عن الحكومات تفاديا للسلبيات التي تنجم عن تغيير هذا المسار كما يقول المقربون منه.
وإثر انتفاضة النجف الأشرف (سنة 1411ه/ 1991م) ضد النظام الصدامي الجائر، وبعد استطاعة الجيش القاسي من اقتحام المدينة المقدسة وانتهاك حرمات أهلها ومقدساتهم، أعتقل سيدنا المرجع (دام ظلّه) مع مجموعة كبيرة من العلماء والفقهاء والعدد الغفير من المواطنين، وقد تعرض سماحته للضرب والاستجواب الغليظ في فندق السلام في النجف أولاً، ثم في معسكر الرزازة التابع لكربلاء ثانيا، ثم في معتقل الرضوانية سيئ الصيت ثالثا، قبل أن يمن اللّه عليه بالفرج.
وقد كشفت وثائق جهاز المخابرات الصدامية لاحقا بعد سقوط النظام أنه قد خطط لاغتيال السيد (دام ظلّه)، غير أن اللّه سلم إنه عليم بذات الصدور.
وبقي السيد المرجع حبيس داره المتواضعة منذ أواخر (عام 1418ه/ 1998م)، لم يخرج خلالها لا لإلقاء بحث ولا لقضاء حاجة حياتية، ولا لغير هذا وذاك، حتى أنه لم يتشرف بزيارة مرقد جده أمير المؤمنين الذي لا يبعد عن داره سوى خطوات قليلة، فقد عاش تلك الفترة المرعبة في جو مليء بمحن وابتلاءات، تنفرج آونة، وتضيق أخرى، وتشتد وتعسر ثالثة، ومنالثالثة أن تعرض ولده سماحة السيد محمد رضا السيستاني إلى محاولة اغتيال في دار والده السيد المرجع (دام ظلّه) نجا منها بأعجوبة وسقط غيره قتيلا في الدار التي انتهكت حرمتها واستبيح أمنها وأمن مرجعها وساكنيها، فإنا للّه وإنا إليه راجعون.
ص: 220
كما تعرض العديد من أعضاء مكتبه في النجف الأشرف قبل سقوط النظام المنهار وبعده إلى محاولات تعدّ مماثلة، وتهديدات بالقتل والتهجير والإساءة، إضافة إلى اعتداءات أوقعت إصابات متوسطة حينا، وأوجبت دخول مستشفى أحيانا، والى ضرب و كلام بذيء وتجاوز غالبا، حتى منّ اللّه عليه وعلى العراقيين جميعا بزوال النظام البائد، ثم بزوال الاحتلال لاحقا(1) (ينظر الملحق العاشر ).
ص: 221
ص: 222
يحسن بي بادئ ذي بدء أن أتحدث عن سيرة سيدنا (دام ظلّه) الذاتية من حيث الولادة والنشأة العلمية والأساتذة والكتب والمصنفات مع ذكر شيء من الاهتمامات المعرفية الأخرى. ثم أنتقل بعد ذلك إلى ماعاناه وأسرته في سجن صدام حسين من محن و مصائب، وما قام به وقامت من دور فعال في أول فرصة سانحة لها وهي في السجن القاسي، ثم أعرج على مرجعيته وما قدمته للطائفة وللمؤمنين، مختتما بما تعرض له من محاولة اغتيال أثيمة وذلك في مطالب عدة هي :
ولد سماحته في مدينة النجف الأشرف، في الثامن من شهر ذي القعدة الحرام عام (1354 ه/ 1935م) في أسرة دينية. يرقى نسبها إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) وهو السبط الأكبر للإمام السيد محسن الحكيم (أعلى اللّه مقامه) المرجع الأعلى للمسلمين الشيعة في عصره
وحظي منذ نعومة أظفاره برعاية والده. وكان مما امتازت به مراحل الشباب عند السيد الحكيم صحبة العديد من الشخصيات العلمية ممن كان والده يعاشرهم ويجالسهم أمثال الأستاذ الكبير الشيخ حسين الحلي (قدّس سِرُّه) الذي كان له أستاذا وأباً روحياً، وخاله
ص: 223
الورع السيد يوسف الحكيم (قدّس سِرُّه)، و الشيخ محمد طاهر الشيخ راضي (قدّس سِرُّه)، وأمثالهم من أعيان العلماء والفقهاء الذين كانت بيوتهم أندية علمية عامرة بالبحث، كما في مجالس المرحوم السيد سعيد الحكيم (قدّس سِرُّه) والسيد علي بحر العلوم (قدّس سِرُّه) والشيخ صادق القاموسي (قدّس سِرُّه) وغيرها من مجالس النجف العلمية والثقافية، التي كانت تفيض بالدروس التربوية والعطاء العلمي الثرّ. وكثيرا ما كنت أشاهده (دام ظلّه) في مجلس جدي السيد سعيد الحكيم (قدّس سِرُّه) وهو يبحث ويناقش ويثري الحوار ويطرح رأيا أو يدحض آخر مستدلا على ما يذهب إليه من رأي بأدلة تشهد على طول باعه وسرعة بديهته ودقة استحضاره وحسن ذاكرته وتبحره في هذا الفن.
ويعد والده السيد محمد علي الطباطبائي الحكيم (قدّس سِرُّه) أول أساتذته حيث باشر تدريسه من أول المقدمات لعلوم الشريعة وأحكامها حتى أنهى على يديه جلّ دراسة السطوح العالية ثم واصل دراسته بعد ذلك عند جده الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدّس سِرُّه)، حيث حضر لديه جملة وافرة من أبواب الفقه وكذلك الشيخ حسين الحلي (قدّس سِرُّه)، حيث حضر لديه في علمي الفقه والأصول. واستفاد من صحبته وملازمته كثيرا حتى وصف تلك الملازمة العلمية بأنها ربما فاقت الدرس نفعا وتحقيقا. وكذلك سماحة الإمام السيد الخوئي (قدّس سِرُّه)، حيث حضر لديه في علم الأصول لمدة سنتين.
بعد أن أتم سماحته عدة دورات في تدريس السطوح العالية للدراسة الحوزوية بدأ في (عام 1388 ه/ 1968م) بتدريس البحث الخارج على كفاية الأصول حيث أتم الجزء الأول منه (عام 1392ه/ 1972م) ثم وفي نفس السنة بدأ البحث من مباحث (القطع) بمنهجية مستقلة عن كتاب الكفاية حتى أتم دورته الأصولية الأولى (عام 1399ه/ 1979م)، ثم بدأ دورة أصولية ثانية.
وقد واصل التدريس والتأليف رغم ظروف السجن القاسية التي مرّت به منذ
ص: 224
عام (1403ه/ 1983م) لحين ( عام 1411 ه/ 1991م). ومن ذلك ابتداؤه بدورة في علم الأصول بتهذيب خلال هذه الفترة العصيبة.
وأما في علم الفقه فقد بدأ سماحته بتدريسه بمستوى البحث الخارج على كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري في (سنة 1390ه/ 1970م) ثم في (سنة 1392ه/ 1972م) بدأ بتدريس الفقه على كتاب منهاج الصالحين للمرحوم السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) وما زال على تدريسه إلى اليوم رغم الظروف العصيبة التي مرّت به خلال سنوات عديدة حيث تخرج على يديه نخبة من أفاضل الأعلام الإجلاء في الحوزة العلمية وهم اليوم من الأساتذة في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة وغيرها.
لسيدنا (دام ظلّه) مجموعة مؤلفات منها : منهاج الصالحين في ثلاثة أجزاء. ومناسك الحج والعمرة و (المحكم في أصول الفقه)، في ستة مجلدات. و(مصباح المنهاج) وهو فقه استدلالي موسع على كتاب (منهاج الصالحين) وقد أكمل منه إلى الآن (1433ه/ 2012م) (16) مجلداً مطبوعا، منها كتاب (الخمس) حيث درَّسنا إياه في سجن أبي غريب وكتبته، وقد كتبه المظلة هو أيضا كعادته في كتابة كتبه كلها إنما في سجن أبي غريب هذه المرة.
وله دورة في (تهذيب علم الأصول) بدأ بها في السجن واقتصر فيها على الأبحاث المهمة من علم الأصول وكتاب في (الأصول العملية) كتبه اعتماداً على ذاكرته في السجن كذلك، وكنت أشاهده يكتب كتابه المذكور على ذاكرته من دون أن يكون بين يديه أي مصدر أصولي للرجوع اليه والاعتماد عليه، وهي حالة نادرة في بابها، ولولا أني كنت شاهدا شهادة عينية على ذلك لتريثت في قبول خبر كهذا لندرته، ولكنه وللأسف
ص: 225
أتلف الكتاب بعد أن أبلغنا أن بعضا من ضباط الأمن والحراس ينوون مداهمة غرفتنا في السجن لتفتيشها، وكان يعني العثور على الكتاب عنده ما يعنيه مما لا يحتاج إلى بيان وله بعد ذلك (حاشية) موسعة على (رسائل الشيخ الأنصاري) (قدّس سِرُّه) في ثلاثة مجلدات. و (حاشية) موسعة على (كفاية الأصول) في خمسة أجزاء و (حاشية) على (المكاسب) في مجلدين. و (تقريرات) ما حضره من درس جده وأستاذه السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) في كتب: (النكاح، والمزارعة، والوصية والضمان، والمضاربة، والشركة) و(تقريرات) بحث أستاذه الشيخ حسين الحلي (قدّس سِرُّه) في (علم الأصول) في جزئين، تشتمل على مبحث الاستصحاب ولواحقه، وباب التعارض. وله جزءان في (الفقه) هي (تقريرات) بحث أستاذه الشيخ حسين الحلي أيضاً. و تقريرات بعض ما حضره عند أستاذه السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه)، وهو جزء واحد من مبحث الواجب التخييري وحتى بداية البراءة. و(رسالة موجهة للمغتربين). و (رسالة موجهة للمبلغين وطلاب الحوزة العلمية). و(رسالة موجهة للعراقيين بعد سقوط النظام البائد) و(رسالة موجهة للتربويين بمناسبة بدء السنة الدراسية الأولى بعد رحيل صدام) و (حوار) أجري مع سماحته حول (المرجعية الدينية) في جزأين أجاب في الجزء الثاني منه عن أسئلتي التي وجهتها اليه متضمنة بعضا من تساؤلات تثار على استحياء هنا وهناك، فكانت إجاباته صريحة ومفصلة وشاملة.
وله كتاب (في رحاب العقيدة) في ثلاثة أجزاء أجاب فيه عن أسئلة أحد العلماء الأردنيين حول الشيعة والتشيع وما يعتمل في صدور غيرهم عنهم. وله كتاب في (فقه القضاء). وآخر في (فقه الكومبيوتر والانترنيت). وله (الكافي في أصول الفقه) في جزأين، وله بعد ذلك كراس في (فقه الاستنساخ البشري) وآخر في (الفتاوى الطبية) وثالث باسم (مرشد المغترب) وقد ألف أخيرا كتابا. مفصلا عن مأساة الإمام
ص: 226
الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أسماه (فاجعة الطف أبعادها. ثمراتها. توقيتها) وقد طبع في (سنة 1429 ه/ 2008م).
للسيد (دام ظلّه) اهتمام خاص بالتبليغ والتواصل مع المؤمنين وتفقدهم وتقصي شؤونهم، وربما رقى المنبر لمخاطبة الجماهير بنفسه والتحدث إليهم في أمور دينهم والإجابة المباشرة عن أسئلتهم وإجراء الحوار معهم، وقد رأيته غير مرة وفي أكثر من مكان يباشر هذه المهمة التي قد لا يباشرها بعض المراجع بنفسه لأسباب شتى. وقد رقى المنبر سنوات لقراءة مقتل الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في العاشر من المحرم وسيأتي ذكر ذلك بتفصيل لاحقا.
و للسيد (دام مظلّه) ولع بقراءة القرآن قاربته من حفظه. وأذكر مرة أنه (دام ظلّه) طلب مني وكنا يومها في (غرفة رقم 16 من ق 2 من الأقسام الخاصة المغلقة من سجن أبي غريب) أن أفتح القرآن يوم أن حصلنا بعد لأي على نسخة من كتاب اللّه يأتينا بها أحد السجناء لفترة محددة خلسة عن أعين الرقباء ليراجع سماحته على سورة يوسف في محاولة منه لاستكشاف ما إذا كانت كثرة قراءته للقرآن جعلته يحفظ هذه السورة دون قصد مسبق منه لحفظها، فقرأها عليَّ من أولها إلى آخرها دون أن يتوقف أو يتباطأ إلا في موردين أو ثلاثة كما أتذكر. وللسيد (دام ظلّه) بعد ذلك رغبة في حفظ عيون الشعر وبخاصة ما قيل منه في واقعة الطف وولع ودأب على حفظ الخطب البليغة وبخاصة خطب نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب وخطب سيدة النساء فاطمة الزهراء (عَلَيهَا السَّلَامُ). وله غير هذا وذاك الكثير مما لا يسعه هذا الموجز.
وله كذلك اهتمام خاص بتتبع كتب العقيدة والتاريخ والسير وليس أدل على ذلك
ص: 227
من كثرة مصادره في بحوثه العقدية و التاريخية فلو أخذنا كتابه (في رحاب العقيدة) بأجزائه الثلاثة أنموذجا لوجدنا أنه اعتمد فيه على (321) مصدرا ومرجعا مختلفا أغلبها من مصادر ومراجع من كتب المذاهب الأخرى، فمن كتب التاريخ رجع مثلا إلى: (البداية والنهاية) لابن كثير المتوفى عام (774ه- / 1372م) و(المختصر في أخبار البشر ) لأبي الفداء صاحب حماة المتوفى (عام 732ه/ 1332م) و (تاریخ بغداد) للخطيب البغدادي المتوفى (عام 463 ه/ 1071م) و (تاريخ الخلفاء) للسيوطي المتوفى (عام 911 ه/1505م) و (تاريخ خليفة بن خياط) المتوفى (عام 240ه/ 854م) و (تاريخ دمشق) لابن عساكر المتوفى (عام 571ه / 1176م) و (تاريخ الأمم والملوك) للطبري المتوفى (عام 310ه/ 922م ) و (التاريخ الكبير) للبخاري المتوفى (عام 256ه/ 870 م) و (تاريخ المدينة المنورة ) لابن شبة المتوفى (عام 262 ه/ 876م) و (تاريخ واسط للواسطي المتوفى (عام 292 ه905 م) وغيرها كثير. ومن كتب التفسير رجع مثلا إلى (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير المتوفى ( عام 774 ه/ 1372م) و(تفسير الطبري ) المتقدم ذكره و (تفسير القرطبي) المتوفى (عام 671 ه/ 1272م) و (تفسير ابن حجر العسقلاني) الشافعي المتوفى (عام 852ه/ 1448م) و (الدر المنثور) للسيوطي المتقدم ذكره و (روح المعاني) للآلوسي المتوفى (عام 1270 ه/ 1854م) وغيرها.
و من السنن رجع إلى (سنن أبي داوود) المتوفى (عام 275ه/ 888م) و (سنن ابن ماجة) المتوفى (عام 275ه/888م ) و (سنن الترمذي) المتوفى (عام 279 ه/ 892م) ه و (سنن الدارقطني) المتوفى (عام 385ه/ (995م) و (سنن الدارمي) المتوفى (عام 255 ه/ 869م) و (السنن الكبرى) للبيهقي المتوفى (عام 458ه/ 1066م) وأيضا للنسائي المتوفى (عام 303 ه / 915م).
ومن الصحاح رجع إلى (صحيح البخاري) (المتوفى عام 256ه/ 870م )
ص: 228
و (صحيح مسلم) المتوفى (عام 261 ه/ 875م) و (المستدرك على الصحيحين) للحاكم النيسابوري المتوفى (عام 405 ه/ 1014م).
ومن المسانيد رجع إلى: (مسند أبي حنيفة) للأصبهاني المتوفى (عام 430 ه/ 1039م) و(مسند أبي عوانة) للاسفراييني المتوفى (عام 316 ه/ 928م) و(مسند أبي يعلى) للموصلي المتوفى (عام 307 ه/ 919م) و(مسند أحمد بن حنبل) المتوفى (عام 07 141ه/ 855 م ) و ( مسند أبي الجعد الجوهري) المتوفى (عام 230 ه/ 845م) و(المسند للحميدي) المتوفى (عام 219 ه/ 834م) و (مسند البزاز ) لأبي بكر البزاز المتوفى (عام 292 ه / 905م) و(مسند الحارث) لابن أبي أسامة المتوفى (عام (282ه895م) و(مسند الروياني) لمحمد بن هارون المتوفى (عام 307ه / 919م) و (مسند الشاميين) للطبراني المتوفى (عام 360ه/ 971م) و (مسند الشاشي) للهيثم بن كليب المتوفى (عام 13 ه/ 947 م ) و (مسند الشهاب) للقضاعي المتوفى (عام 454ه/ 1062م) و (مسند الطيالسي ) لسليمان بن داود المتوفى (عام 204 ه / 819م) و (مسند عبد بن حميد) المتوفى ( عام 249 ه/ 863 م ).
وكذلك لمصادر مثل: (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) لابن حجر رجع العسقلاني المتوفى (عام 852ه/ 1448م) و(المحلى) لابن حزم الظاهري المتوفى (عام 456ه/ 1064م) و (المغني) لابن قدامة المتوفى (عام 620 ه/ 1223م) و(منهاج السنة) لابن تيمية المتوفى (عام 728 ه/ 1328م) و (الموطأ) لمالك بن أنس المتوفى (عام 179 ه/ 795م) و (نيل الأوطار) للشوكاني الزيدي المتوفى (عام 1255 ه/ 1839م) وغيرها كثير مما يكشف عن باع طويل في الإحاطة والمراجعة والتتبع والاطلاع.
وقد حذا في كتابة كتابه (فاجعة الطف أبعادها. ثمراتها. توقيتها) حذو كتابته في (في رحاب العقيدة) بل زاد عليه في عدد مصادره - مع أنه جزء واحد- حيث رجع فيه إلى
ص: 229
(332) مصدرا و مرجعا تاريخيا معتبرا.
ومما يلفت النظر حقا أنه (دام ظلّه) لم يتوقف اهتمامه بالبحث والتحصيل حتى في حجز وسجن النظام البائد، فقد اعتقل مع أسرته آل الحكيم من عام (1403ه- 1411 ه) (1983م - 1991م) وتنقل مع أسرته من سجن إلى سجن حتى انتهى به وبنا الأمر إلى قسم الأحكام الخاصة المغلقة من سجن أبي غريب / صدام، ففي هذه الأقسام المغلقة وتحت ظروفها القاسية الممضة ابتدأ سماحته بأحياء المناسبات الدينية التي كانت تتضمن من جملة ما تتضمن محاضرة يعدها هو ويلقيها على طلابه وأبنائه من أفراد أسرته مطيبة بآيات قرآنية كريمة وأحاديث وروايات شريفة ومواعظ وحكما مختلفة تحث في غالبيتها على الصبر والتحمل والمجالدة والتبصر درج على أن يتصدى بعد انتهائه منها وإنشاد قصيدة لي بالمناسبة كما جرت العادة للإجابة عن استفسارات السائلين وأسئلتهم الفقهية والعقائدية المختلفة مما كان له أعمق الأثر في تخفيف المعاناة عنهم وتعميق توكلهم على اللّه عز وجل والالتجاء إليه والاستعانة به في كل أمر ونازلة.
وكان سماحته قد بدأ درساً في التفسير خفية عن عيون السجانين في القاطع الخامس من سجننا بمديرية الأمن العامة بحدود أوائل عام (1404ه / 1984م) إن لم تخني الذاكرة حضرته مع جمله من حضره من الأرحام من أمثال السادة أولاد العم الثلاثة الذين أعدموا لاحقا وهم الشهداء: السيد محمد رضا، والسيد محمد، والسيد عبد الصاحب أبناء العم العلامة المجتهد الفقيد السيد محمد حسين الحكيم (قدّس سِرُّه) ومعهم المرحوم المجتهد السيد عبد الرزاق الحكيم، والسيد محمد جعفر السيد محمد صادق الحكيم، والسيد محمد حسين السيد محمد صادق الحكيم، وغيرهم، وقد توقف عنه (دام ظلّه) بعد اكتشاف العيون أمره، مما كاد أن يعرضه ويعرضنا إلى ما لا تحمد عقباه.
كما شرع سماحته بعد نقلنا الي سجن أبي غريب بتدريس طلابه منهم على مستوى
ص: 230
بحث الخارج درسين أولهما في الفقه وثانيهما في أصول الفقه حضره ولداه السيد علاء الدين والسيد عز الدين، وكانت الثمرة كتابا في أصول الفقه أكمله بعد خروجه من السجن أسماه (الكافي في أصول الفقه).
كما شرع سماحته أوائل (عام 1404ه / 1984م) استجابة منه لطلبي بدرس في الموعظة والأخلاق حضره معي أخوه السيد محمد صالح الحكيم، كما صنف كتابا في مباحث (الأصول العملية) معتمدا فيه على ذاكرته لعدم وجود مصدر عنده في السجن آنئذ ثم اضطر إلى إتلافه على مضض خشية عثور الجلاوزة عليه أثناء تفتيشهم للسجن كما تقدم.
ثم كتب بعد ذلك كتابا داخل سجن أبي غريب في مبحث (الخمس) متضمنا بعضا من البحوث الفقهية المعمقة على مستوى البحث الخارج، وكتابا في سيرة النبي والأئمة، ولا زلت أذكر وقد سجنت مع السيد المرجع في غرفة واحدة طوال فترة السجن المريرة التي أربت على ثمان سنوات أني طلبت منه أن يدوّن بعض الأحاديث الشريفة في نعمة الموالاة والموالين الصابرين وما يلقاه الممتحنون المبتلون من عظيم الثواب ورفيع المنزلة متى صبروا، لتقوى به عزائم المظلومين و تشحذ به هممهم وتزداد به قدرتهم على تحمل صنوف المعاناة والعذاب فوعد أن يكتب ما تجود به عليه ذاكرته من نصوص كريمة، ووفى (دام ظلّه) فكتب مجموعة من الأحاديث الشريفة بنصوصها التي وردت فيها والتي كان لها دور في تخفيف آلام المعذبين المقهورين، وشد أزرهم وزيادة توطنهم على ما هم فيه من العذاب والبلاء، كما كتب كتاباً عن (مقتل الإمام الحسين) (عَلَيهِ السَّلَامُ).
وما دام قد وصل بي الحديث إلى هذا الموضع فإنه يحسن بي أن أقول انه كتب (مصرع الإمام الحسين) (عَلَيهِ السَّلَامُ) كاملا في غرفة رقم (15 من ق 2) من قسم الأحكام الخاصة المغلقة من سجن أبي غريب / صدام في بغداد، وقد مرّ علينا حينها يوم عاشوراء فدوّن
ص: 231
سماحته المقتل ووقائعه ابتداء من موت معاوية وحتى آخر الواقعة المأساوية الفاجعة بتفاصيلها الدقيقة من نصوص خطب الإمام الشهيد الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مكة، وفي الطريق إلى كربلاء، وفي كربلاء.. إلى أسماء الشهداء من الأنصار.. إلى أسماء الشهداء من آل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) الأول فالأول منهم، ومن قتلوا، وقاتليهم بأسمائهم وأنسابهم.. إلى شهادة الأمام السبط (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وما جرى فيها، وكيف جرى ما جرى؟.. إلى نص دعائه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعد سقوطه عن الفرس إلى ما بعد مصرعه (عَلَيهِ السَّلَامُ) من تفاصيل.
كل ذلك على ذاكرته لعدم وجود مصدر لديه في السجن، فهو لم يغفل عن ذكر شاردة ولا واردة إلا أتى عليها وذكرها مما أثار باستحضاره وحفظه لدقائق (المصرع) دهشتي و دهشة السجناء الآخرين.
ونتيجة لعدم وجود ورق ولا أقلام كان عليه أن يكتب على ما تجود به غرف المساجين من علب التدخين الفارغة، فيجمعها له جامع، ثم ينقعها هو بالماء داخل أجانة ماء من الليل إلى الصباح، حتى إذا أذاب الماء الصمغ، وأمكن للعلبة أن تفتح لواصقها، قطع أطرافها السائبة لتصبح ورقة بحجم راحة الكف، فيجفف الورقة كي تكون الكتابة عليها ممكنة.
عندها يقوم بفرز أوراق علب السجائر فيأخذ الصافية الخالية من أثر الصمغ لكتابته هو ويترك الأخرى الأقل جودة لي لأنظم عليها الشعر مقدمة لإنشاده في يوم الإحياء القادم.
وكانت كل ورقة منه ومنها هدية أعتز بها، حتى إذا قدر لي أن ألتقي بالأهل بعد أول مواجهة لي معهم منذ أربع سنوات من السجن القاسي – مع مجهولية مصيري ومصيرهم - عرضت عليهم - وأنا مشفق - مهمة حمل الأوراق وإخراجها معهم من
ص: 232
السجن، منبها إياهم على خطورة ما هم مقدمين عليه من أمر فيما لو اكتشف الحرسي أو الشرطي المفتش أو المفتشة أمرهم عند تفتيشهم وهم خارجون من مواجهتي. حينها لا قدر اللّه سيعني لهم ذلك ولي ما يعنيه، فتوطنوا على الأمر، وتحملوا المجازفة على ما فيها من مخاطرة، نزولا عند رغبتي، أو حرصا منهم عليها، أو الاثنين معا.
وقد فعل سماحته بكتاباته مثل ما فعلت، حيث لم تكن عنده وعندي وسيلة أخرى محتملة، ومرت الساعات بين وداعي لعائلتي وأطفالي وتنفسي الصعداء ثقيلة بطيئة متكاسلة، حتى إذا جنّ الليل ومضى زمن على مغادرة زوجتي وولدي يسار ومحمد خمنته كافيا لاجتيازهم قاطع التفتيش من دون أن أستدعى للتحقيق ولما لا تحمد عقباه، تيقنت بنجاح مهمتهم في العبور بسلام، فسجدت للّه شكرا، واطمأننت.
ولا زالت أوراق السجائر المكتوبة وغيرها على حالها مصونة محفوظة عنده وعندي للتذكر والتوثيق والاعتبار.
هذا وكان السيد المرجع - أو السيد المجتهد كما كان يحلو للسجناء أن يطلقوا عليه - شديد التعاطف معهم يسمع منهم شكاواهم ويحاول التخفيف عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا وأذكرانه في مرة من المرات صادف أن توفي فجأة أحد المساجين من الأخوة التركمان المظلومين اسمه (عيسى)، وكان شابا قوي البنية صحيح الجسم، فأثارت وفاته المفاجئة بين أيدي أخوته المساجين الضعفاء وتحت أبصارهم حالة من الفجيعة الشديدة والبكاء والعويل، تبعته حالة من الانهيار المعنوي والانكسار النفسي، مما زاد السجناء غربة على غربة، وضيقا على ضيق فكان أن بادر (دام ظلّه) إلى إلقاء كلمة في السجناء المكسورين يعزيهم ويسليهم ويصبرهم ويقويهم ويرفع معنوياتهم المنهارة، وحين طلب منه بعض السجناء من داخل غرفهم المغلقة أن يروه من وراء قضبان سجنه المغلق وهو يتحدث إليهم تسلق سماحته قضبان الحديد لكي يراهم ويروه فكان لهم ما أرادوا
ص: 233
وكانت تلك من المرات النادرة التي أرى فيها مجتهدا كبير السن يتسلق قفص السجن بهذه الصورة.
وأذكر كذلك أنه رفض بشدة طلباً لأحد مسؤولي السجن قضى بنقل الأسرة إلى قسم في سجن أبي غريب يسمى ب(القسم التأهيلي) بدعوى التوسعة علينا وعلى السجناء الآخرين إذا ما شغلوا مكاننا بعد نقلنا، وكان سبب رفضه الشديد لذلك تفسيره لنقلنا بأنه عزل للأسرة عن السجناء الآخرين، وتعطيل لفرص التبليغ والتواصل، وتخفيف المعاناة عنهم، وهو ما كان يحرص عليه باستمرار.
وحين اضطرت الأسرة إلى مغادرة غرفتيها نزولاً عند أمر السجانين لهم بذلك، قرر سماحته أن يمرّ على غرف السجناء غرفة غرفة، ليودعهم ويشحذ فيهم العزائم والهمم، ويوصيهم بالصبر والتحمل، ويذكرهم بعظم جزاء الصابرين في جو مشحون بالعاطفة والود والتأثر والبكاء.
وفي فترة التحقيق الثانية بعد الانتفاضة الشعبانية (عام 1411 ه/ 1991م) حيث نقل إلى معتقل الرضوانية سيء الصيت للتحقيق معه، الصيت للتحقيق معه، كان يومها يرأس لجنة التحقيق آنذاك المجرم المقبور صدام كامل التكريتي صهر الدكتاتور، وقد استخدمت مختلف أساليب التعذيب مع سماحته من أمثال الضرب الموجع بالهراوات واستعمال الأسلاك الكهربائية وغيرها، ورغم ذلك كله ظل صابرا رابط الجأش مستعينا بالواحد الأحد في مواجهة جلاديه حتى دهشوا من صموده،وإصراره، ما حدا بصدام كامل أن يقول له: لماذا لا تعترف ؟ إن جسمك لا يتحمل هذا التعذيب كله، فاعترف كي تخلص. ولم يقتصر صموده على ذلك، بل كان يخفف عن باقي المعتقلين ويسليهم ويمازحهم لتقوية عزائمهم وشحذ هممهم على التحمل والصبر والتعلق بالله عز وجل في الشدائد واللجأ إليه في النوازل وترك الاستعانة بغيره من خلقه، فهو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.
ص: 234
هذا بعض مما قام به السيد (دام ظلّه) من دور علمي وتربوي واجتماعي وما لاقاه من محن وآلام في السجن وخارجه قبل التفجير وأثناءه وبعده مما لا يسع المجال لذكرها واستعراضها، جعلها اللّه في ميزان حسناته وأثابه عليها أضعاف ما ابتلاه بها، إنه خير مسؤول..
بعد رحيل السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) كثر الرجوع إلى سماحته وتزايد الإلحاح عليه بالتصدي للمرجعية من قبل مجاميع من المؤمنين والفضلاء في الحوزة العلمية منهم بعض من كبار العلماء ومراجع الدين. فكان أن تحمّل المسؤولية في الظروف الحرجة والمعقدة التي يمرّ بها المؤمنون في مختلف بقاع المعمورة مهتما بتنشئة جيل من الطلاب في النجف الأشرف يعيدون للحوزة العلمية سابق عهدها بعد ما لاقته من عنف محاربة النظام لها هذه المدة المديدة كلها موليا الجاليات المسلمة البعيدة عن الحواضر الإسلامية أهمية خاصة. مركزا على الانفتاح على طوائف المسلمين كافة حريصا على مصلحة الإسلام والمسلمين محاربا التعصب الأعمى مذكرا باستمرار بالمشترك الجامع بين المذاهب الإسلامية من الأصول الكبرى والأحكام وبالمشترك الجامع بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى وقد حضرت مرة استقباله في لندن أثناء زيارته لها لوفد من رجالات الكنيسة عاده متمنيا له السلامة من مرضه فرحب به أيما ترحيب وتحدث معه مطولا عن أهمية الحوار والتواصل بين الكتابيين على اختلاف دياناتهم لما فيه من خير وصلاح وفائدة.
للسيد الحكيم (دام ظله) مشروع عون وإغاثة يتضمن تخصيص رواتب شهرية لآلاف العوائل المتعففة في العراق تلك التي مرت وتمر بظروف اقتصادية عصيبة جراء الظلم
ص: 235
والحيف، إلى جانب تعمير مجموعة من الأماكن والعتبات المقدسة المتداعية أو التي أشرفت على الانهيار بسبب انعدام الرعاية اللازمة لها، مثل مشروع بناء وتجديد (مسجد السهلة) الكبير، وكذلك مرقد (القاسم ابن الإمام الكاظم) (عَلَيهِ السَّلَامُ)، و له ولمكاتبه نشاطات عديدة في مناطق وأماكن مختلفة تقدم الخدمات الإسلامية الأساسية للمؤمنين كإنشاء مدرسة، ومستوصف، ورعاية الأيتام من خلال مؤسسة كبيرة تجاوز عدد الأيتام فيها هذه السنة 2012م (70) الف يتيم ويتيمة في أنحاء العراق كافة، وتولي المرجعية أمر الفقراء والمساكين والمعوزين اهتمامها العالي داخل العراق وخارجة وخاصة في الدول الفقيرة كأفغانستان،وغيرها وللمرجعية مركز ثقافي في جورجيا السوفيتية، ولها مساجد تبنى في الصين، ومسعى حثيث للانفتاح على مؤسسات أكاديمية وبحثية وكتاب ومفكرين أجانب وخاصة من أوربا وأمريكا واستراليا وأفريقيا وغيرها من خلال زيارات متبادلة ولقاءات علمية لاقت انطباعا جيدا عندهم وعكست صورة إيجابية جدا عن فكر وفقه وحضارة واعتدال مذهب آل بيت النبي الأكرم محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)، بدت واضحة من خلال كتاباتهم بعد عودتهم إلى بلدانهم وجامعاتهم ومراكز بحوثهم المختلفة.
وهناك نشاطات أخرى لا يسع المجال لذكرها هنا.
هذا وللمرجعية وكلاء منتشرون في العديد من بلدان العالم في شرق الأرض وغربها لإيصال صوت المرجعية وخدماتها إلى المؤمنين ورد الشبهات وتوجيه المبلغين وتقديم صورة عن حوزة النجف الأشرف وآرائها وطروحاتها في تلك الدول.
ص: 236
لم يدر بخلدي وأنا أودع سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم مغادرا مكتبه في النجف الأشرف قبل ظهر يوم (25/ جمادى الثانية/ 1424 ه- 24/ آب / 2003م) أن سماحته سيكون عرضة لمحاولة اغتيال أثيمة بعد نصف ساعة من توديعي إياه، وأن مكتبه وجداره الخارجي القديم الذي وقفت جنبه لاستقل سيارة أجرة وأرحل سيكون ساحة للتفجير والتخريب بعد قليل.
وما أن وصلت منزلي حتى دوى انفجار عنيف زلزل المكان وترددت أصداؤه في جنبات مدينة النجف الأشرف القديمة فهدمت منزلا هنا، وحطمت زجاج منزل هناك، ودب الخوف والرعب في قلوب الكبار والصغار وعلت صرخات النساء لتملأ المكان استغاثة وفزعا ثم لينجلي الموقف بعد ذلك عن بركة دماء قانية تحوط ثلاث جثث تناثر أشلاء بعضها على جدران البيت وشبابيكه، إضافة لثلاثين جريحا جراح أحدهم خطيرة، لقد كان من بين الجرحى سماحة السيد المرجع الكبير (حفظه اللّه ورعاه) نفسه حيث أصيب بشظايا الزجاج المتطاير، إضافة لاضرار مادية منها تهديم واجهة مكتب السيد المستهدف، وهو ما كان يجلس عادة خلفه، وتهديم لبعض الدور السكنية المجاورة، وتكسير لزجاج النوافذ المحيطة بالمنطقة. واهتزازات للمباني هنا وهناك، خلَّفت ما تخلفه الاهتزازات من ندوب وشقوق وتصدعات (1) (ينظر الملحق. العاشر).
ص: 237
ص: 238
وفيه مطالب عدة هي:
ولد محمد إسحاق سنة (1349 ه/ 1930م) في قرية (صوبة) إحدى قرى محافظة (غزني) في وسط أفغانستان الواقعة جنوب العاصمة كابل، وهو ثاني أبناء والده محمد رضا من بعد أخيه محمد أيوب، وكان والده رحمه اللّه المتوفى سنة (1409 ه/ 1989م) فلاحاً بسيطاً يعمل عند بعض المتمولين في القرية من ملاك الأراضي، ليقتات من كدّ يمينه وعرق جبينه في إعاشة عياله، إلّا أنه كان غنياً بالإيمان، مشفوعاً بحب الرّسول الكريم وآله الأطهار صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين. وقد كان يرى ذلك المؤمن المزارع البسيط في ولده محمد إسحاق من علامات النبوغ والذكاء ما ألزمه أن يوليه إهتماماً ورعاية خاصة وكأنه يقرأ في ملامح ولده منذ ولادته ما يكون عليه الوليد في مستقبل الأيام فكان يرسله والده إلى مكتب شيخ القرية يومياً حيث لا توجد مدارس نظامية في القرية آنذاك - ليتعلم مبادئ القراءة والكتابة وتعلم القرآن، وهو في الخامسة من العمر، وفي فصل الشتاء، يحمل الوالد الكريم صغيره على ظهره مغطياً إياه بما يكفي لحمايته من البرد القارص عبر الطرق الوعرة والثلوج الكثيفة، ليوصله إلى مكتب
ص: 239
الشيخ صباحاً ويعود به إلى البيت مساءً وهكذا ليتغذى الولد من منأهل العلم والمعرفة والأخلاق، وينعم بالعطف والحنان، فيشب على الإيمان وحب آل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) ويقرر إكمال دراساته في الحوزات الدينيّة كما كان ذلك رغبة والده رحمه اللّه، فقرأ على شيخ القرية أبجديات العلوم وتعلم القرآن، ومن ثم كتاب (جامع المقدمات) وهو كتاب يشتمل على أكثر من عشر كتب مختصرة في النحو والصرف والمنطق والأخلاق لعدة مؤلفين، يدرسها طلاب العلوم الدينية كمقدمة للكتب اللاحقة المقررة في الحوزات.
ثم إنتقل الطالب بعد مكتب شيخ القرية إلى قرية (حوت قل) المجاورة. حيث أكمل في تلك المدرسة قراءة كتاب (جامع المقدمات) وكتاب (البهجة المرضية في شرح الألفية) المعروف في الأوساط الدراسية بكتاب السيّوطي نسبة إلى مؤلفه جلال الدين السيوطي المتوفى (سنة 911 ه / 1505م) في النحو وقواعد اللغة العربية لأربع سنوات.
وكان نظام المدرسة حينها يكفل للطالب مكان الإقامة والمبيت في إحدى غرفها الصغيرة، وعلى الطالب أن يتكفل بمصاريفه الشخصية من اللباس والطعام الذي كان عادة ما يتكون من جلب الطحين من منازلهم لتقوم بعض نساء القرية بعجنها وعملها خبزاً للطلاب من دون أجر.
وفي تلك الفترة فقد محمد إسحاق والدته رحمها اللّه حيث وافاها الأجل المحتوم أثر مرض ألم بها فحزن لفقدها وتألم كثيراً، إلّا أنّ المصاب رغم فداحته، لم يثنه عن مواصلة التعلم، بل زاده إصراراً حتى قرر الإنتقال من مدرسة القرية إلى مدينة مشهد المقدّسة في إيران، وذلك كخطوة أولى منه، لما يدور في ذهنه ويعمل من أجله بشغف بالغ متمنياً تحقيق أمنيته، ألا وهو الإنتقال إلى الحوزة العلميّة الدينية العريقة في النجف الأشرف في العراق.
ص: 240
لقد إستقر الشيخ محمّد إسحاق سنة واحدة في مدرسة (الحاج حسن) الواقعة في منطقة (بالاخيابان) والتي شملها مشروع توسعة الحرم الرضوي فيما بعد، فتهدمت المدرسة ووقعت ضمن الساحة الكبيرة للحرم المقدس حالياً، قرأ خلالها كتاب (حاشية ملا عبدالله) على كتاب (تهذيب المنطق ) للمولى عبد اللّه بن شهاب الدين الحسيني المتوفى (981 ه- / 1573م)، ومقدار من كتاب (المطول) لسعد الدين التفتازاني، في علم المعاني والبيان والبديع عند الأستاذ الشيخ محمّد حسين النيشابوري المعروف (بالأديب النيشابوري) رحمه اللّه.
بيد ان تلك الغربة لم تكن تعني سوى المزيد من الإصرار على بلوغ الشيخ لمرامه من الوصول إلى الحوزة العلميّة الدينيّة في النجف الأشرف في العراق، وهو في بحث وسؤال دائمين حول طريق السفر، حيث كان قد ترسخ في ذهنه – وهو طالب صغير في قريته - أهمية النجف الأشرف وخصوصيته لما كان يسمعه من فضل النجف مدينة وحوزة على غيرها من المدن والحوزات، وذلك مما يدور في أحاديث الطلبة وأساتيذهم وبخاصة العلماء الذين كانوا قد تخرجوا من النجف الأشرف واستقروا في مناطقهم، أو من أولئك الذين كانوا مازالوا مستمرين في النجف الأشرف ويترددون في زيارات إلى أهليهم، فينقلون في مجالسهم ومحاضراتهم الخصوصيات والميزات بين الحوزات التي زاروها أو استقروا لبعض الوقت فيها، ويذكرون أفضلية النجف على غيرها، يقول الشيخ الفيّاض في هذا الصدد أول ما سمعت باسم النجف ومرتبة الحوزة العلمية فيها، كان من شيخ قريتنا، ومن ثم في المدرسة الدينيّة، وكلما كنا نسمع عن النجف الأشرف حديثاً كنا نسمع أيضاً عن الأستاذ المبرز فيها، ألا وهو السيّد الخوئي (قدّس سِرُّه)، وذلك بواسطة الأفاضل من تلامذته أمثال الشيخ عزيز الكابلي، والسيّد محمد حسن الرئيس والشيخ محمّد علي المدرس رحمة اللّه تعالى عليهم أجمعين.
ص: 241
لقد إنتقل الشيخ الفياض بعد عام من الدرس في حوزة مدينة مشهد – كما تقدم – إلى مدينة قم المقدسة لزيارة قبر السيّدة المعصومة أخت الإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) ومنها شد أزره للسفر إلى العراق.
وصل الطالب الجديد إلى النجف الأشرف وهو شاب في مقتبل ربيعه الثامن عشر، وقد مرّ في طريقه إليها -كما تقدم - بتجارب عديدة أصقلت مواهبه وعلمته بعض مصاعب الحياة على إختلاف أنواعها والفرق بين نظم العيش والأخلاق والعادات في مدن عديدة مختلفة، إلّا أنّ للنجف الأشرف كمدينة وللحوزة العلمية فيها كمدرسة، صعوباتها وظروفها الخاصة ومتاعبها كما هي العادات والتقاليد المختلفة بين الشعوب والبلدان، مقابل ما لها من خصوصيات إيجابية في مقدمتها بركة وجود مرقد أمير المؤمنين الإمام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، والإنفتاح والتقدم العلمي لحوزتها الدينيّة التي أهلتها أن تتصدر الحوزات الأخرى وتتزعم قيادتها وتخرج آلاف العلماء وتستقر فيها المرجعيّة العليا للطائفة، ولينشد إليها أفكار وأنظار طلاب وعشاق علوم أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) ومواليهم من جميع نقاط العالم.
لقد كان يتحتم على النزيل الجديد التكيف مع تلك الظروف وتحمل صعابها بحجم قدرته في الإصرار والمثابرة على الإستمرار، إبتداء من تحمل مناخها الحار الشديد صيفاً والبارد القارص شتاء، إلى ضرورة تعلم اللغة العربية أوّلاً للواردين إليها من غير المتكلمين بها، والبحث عن مكان مناسب للإقامة والتفتيش بين مئات الحلقات الدراسية الموجودة والمنتشرة في عشرات المدارس والمساجد في أطراف المدينة للعثور على الحلقة المناسبة للتلميذ من حيث المستوى والأستاذ والمباحث، وكيفية الحصول على الكتب الدراسية المنتظمة أو تلك التي يحتاجها الطالب لمطالعاته الخاصة في الحقول
ص: 242
المختلفة، إلى التعرف على الطلاب الآخرين ومستواهم العلمي والأخلاقي لإختيار البعض منهم كزملاء في البحث والدرس، إلى ضرورة تأمين المواد اللازمة للمأكل والملبس وضرورات،العيش،وغيرها، يقول الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض في هذا الصدد: كان قدومي إلى النجف الأشرف بسنوات بعد وفاة المرجع السيد أبو الحسن الأصفهاني (قدّس سِرُّه)، وفي أواخر فترة العهد الملكي، وأوائل فترة مرجعيّة السيّد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) الذي كان قد أجرى راتباً شهرياً للطلبة بمقدار دينارين للطالب المعيل ومبلغ دينار للطالب الأعزب من أمثالنا، وكنا غالباً ما نأكل الخبز والبصل، ولا يخطر ببال أحدنا أن يأكل يوماً شيئا مما يسمى بالفواكه.
وما إن إستقر المقام بالضيف النزيل عند أحد الطلاب من بني قومه الذي كان قد سبقه إلى النجف الأشرف مشاركاً إياه في غرفة صغيرة من غرف مدرسة (السليمية) حتى بدأ بزيارة العلماء والمراجع لأداء واجب الإحترام، والتعرف عليهم عن قرب، وطلب التوجيه والإرشاد منهم في المهمة التي نذر نفسه اليها، كما قام بزيارة عدد من المدارس والمساجد التي تكتظ بالأساتذة وجموع الطلبة في حلقات الدرس والبحث هنا وهناك، وقد كان عونه في تلك الأمور سماحة العلامة المغفور له الشيخ محمد علي الأفغاني المعروف ب (المدرّس) والذي كان من المهتمين والمتابعين لتسهيل وإنجاز أمور الطلبة وقضاء حوائج بني قومه من الطلبة وبخاصة الوافدين الجدد منهم، وهو الأستاذ البارع الشهير لمرحلة المقدمات والسطوح، ولذلك لقّب بالمدرّس فقط أخذ الشيخ الفياض معه إلى زيارة المرجع المرحوم آية اللّه السيّد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) في مجلسه العام وزار المرجع السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه) في منزله لعلاقة الشيخ المدرّس الخاصة به وقربه منه.
ورغم مضي أشهر منذ أن حط رحاله في المدرسة فقد بقي الشيخ محمّد إسحاق
ص: 243
يشارك مضيفه الشيخ غلام حسين في غرفته الصغيرة في مدرسة السليمية، حتى قرّر زميله إكمال نصف دينه بالزواج وقد وفقه اللّه تعالى لذلك، فترك الإقامة في المدرسة وانتقل إلى منزله الجديد، وإستقر الشيخ محمد إسحاق في الغرفة منفرداً بها، منكباً على الدرس والبحث والمطالعة والكتابة.
إنتقل الطالب (المرجع لاحقا) إلى دراسة مرحلة السطوح ليتأهل لحضور بحوث الخارج لدى العلماء الكبار، فقرأ كتاب (الكفاية) للشيخ الآخوند الخراساني، وكتابي (الرسائل) و (المكاسب المحرّمة) للشيخ مرتضى الأنصاري عند المرحوم الشيخ مجتبى اللنكراني (قدس اللّه أسرارهم) كما كان في تلك الفترة يتباحث في الكتب التي يدرسها مع بعض زملائه، ويدرّس ما فرغ من تحصيله إلى الطلبة المبتدئين من بعده، كما هو المتعارف في نظام التعليم في الحوزة الدينيّة في النجف الأشرف، حيث يتمرّن الطالب منذ البدء، على تعلم نظام التدريس وهو يدرس مرحلة أعلى، فهو تلميذ وأستاذ في وقت واحد، وتسمّى تلك المرحلة في عرف الحوزات الدينيّة بمرحلة السطوح التي تستغرق حوالي خمس سنوات للطالب المجد والمثابر، والتي إنتهى منها الشيخ الفيّاض بأقل من تلك المدة، وسرعان ما التحق بحلقات بحوث كبار العلماء لمرحلة البحث الخارج.
فبعد أن وقف الشيخ الفياض على الآفاق الرحبة للفكر الإسلامي واعتاد الأجواء العلميّة والروحانية منها في مراحل دراسة السطوح، حيث الكتب الدراسية المعهودة التي قرأها على أفاضل علماء وأساتيذ الحوزة العلمية المتقدم ذكرهم ثم انتقل إلى حضور (البحث الخارج) فحضره، وهو في بدايات العشرين من عمره، واختار حلقات بعض الأساتذة الكبار من علماء النجف القديرين لعدة أشهر، حتى إستقر على بحث أستاذه الذي اشتهر طلابه به وإشتهر بهم، فكلما ذكر السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي ذكر
ص: 244
معه السيد محمد الروحاني والشهيد السيد محمد باقر الصّدر والسيد علي الحسيني السيستاني والمترجم له وغيرهم من أفاضل تلامذته، كما أنه لو ذكر أحدهم لازمه ذكر السيد الخوئي أستاذاً له.
وقد إستمر الشيخ الفيّاض على هذا الدرس يومياً لأكثر من خمسة عشر سنة دون انقطاع في حلقتي الفقه والأصول، مواظباً ومتابعاً ومقرراً للبحث.
لقد دأب الشيخ الفيّاض منذ حضوره بحث أستاذه المرجع السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) على تقرير البحث على بعض زملائه في الدرس بمعنى أن يعيد درس أستاذه بعد مضي بعض الوقت عليهم كما كان مواظباً على كتابة درسه يوماً بعد يوم سواء في مادة الفقه أم الأصول، حتى أكمل تقرير الدورة الخامسة من دورات بحث أستاذه السيد الخوئي في علم أصول الفقه، فكان الكتاب المعروف ب (المحاضرات ).
و يحكى أنه لما قدم الشيخ الفيّاض تقريرات بحوث أستاذه لإجازته في طبعها، كان بعض ممن يخالف إجازتها معترضاً على السيد الخوئي، بحجج واهية غير مستندة على منطق سليم، كعمر الطالب وانتمائه القومي، وكان السيد الخوئي يقول في ردهم : إن المناط هو علم الطالب وفضله، وما يدل من تقريراته على جهده واجتهاده وذكائه وعمله الدؤوب ومتابعته وقوة ملاحظاته، وليس المناط،عمره، فإنه كانت الإعتراضات هذه وشبهها على أساس صغر سني آنذاك، تحاول منع أستاذي الشيخ النائيني (رَحمهُ اللّه) من إجازته طبع تقريرات بحوثه التي كتبتها (أجود التقريرات) فإنه يجب إنصاف الحق وإعطاء كل ذي حقٍ حقّه، كما ينبغي تشجيع الطالب المجد والمثابر ودعمه للاستمرار على ذلك النهج.
ص: 245
وبالفعل فقد أجاز الأستاذ السيد الخوئي طبع التقريرات تلك مع الإشادة بمقررها
وقد وفق اللّه سماحته في إتمام طبع الأجزاء الخمسة من تقريرات أستاذه في علم أصول الفقه، وهي تعد اليوم من أهم المصادر العلميّة في ذلك الفن، يتداوله العلماء والطلاب العلوم الدينيّة في كثير من الحوزات درساً وتدريساً ومطالعة ومراجعة للوقوف على الآراء الجديدة والأفكار والنظريات التي تحتويها.
وهكذا وخلال تلك الفترة وما بعدها، كان المرجع الشيخ الفيّاض (دام ظلّه) واحداً من الأساتذة المشهورين في الحوزة، حيث يلقي دروسه وبحوثه على جمع كبير من الأفاضل من طلاب العلوم الدينيّة، حيث يدرس خلالها الكتب المعهودة لمستوى السطوح العليا وهي (الرسائل) و(الكفاية) و(المكاسب) في حلقات متعددة في المسجد الهندي المعروف، كما كان أستاذ هذه المرحلة لأكثر من عشر سنوات في (جامعة النجف الدينيّة) التي أسسها المرحوم السيّد محمّد كلانتر وبعدها بدأ بإلقاء بحوث الخارج على طلبته عام (1398ه/ 1978م) في مدرسة السيّد اليزدي الصغرى الواقعة في محلة العمارة، وعند إفتتاح مدرسة (دار العلم) المعروفة التي أنشأها السيد الخوئي عام ( 1400 ه/1980م) إنتقل مجلس بحثه إلى هناك حتى تاريخ هدم المدرسة على يد أزلام النظام البائد بعد الانتفاضة الشعبانية الكبرى عام (1411 ه/ 1991م)، فانتقل مجلس الدرس إلى المسجد الهندي الكبير في فترة قليلة، ومن ثم إلى مدرسة اليزدي، وهي مدرسة أسسها المرجع السيد كاظم اليزدي (قدّس سِرُّه) حيث استمر على التدريس فيها لأكثر من عشر سنوات حتى سقوط النظام البائد ثم انتقل مجلس بحثه إلى مكتب سماحته قرب داره للظروف الأمنية وإلى اليوم، ويحضر درسه اليوم جمع كبير من الطلبة وفيهم غير واحد من الأفاضل ممن يقرّر بحوث المرجع الشيخ الفياض على أمل طبعها إن شاء الله تعالى.
ص: 246
وإذ تعارف لدى المراجع العظام تشكيل لجنة من خاصة المقربين إليهم من أفاضل تلامذتهم والعلماء المبرزين تسمى ب(لجنة الإستفتاء) للإجابة على السيل الكبير من الرسائل والإستفسارات الواردة إليهم من مختلف نقاط العالم من مقلديهم، وذلك بعد التمحيص والبحث والمناقشة والتحقيق حتى الوصول إلى الرأي الشرعي الصحيح بنظرهم مع موافقة المرجع لكتابته في الجواب على السؤال الوارد، وهو ما قد يستغرق البحث في مسألة واحدة عدة أيام قبل إمضائها.
وهو ما دعا المرجع الراحل السيد الخوئي أن يشكل لجنة الإفتاء من العلماء والمجتهدين الكبار من تلامذته للقيام بهذه المهمة، وقد كان سماحة الشيخ الفيّاض لما يملكه من مؤهلات عالية من فضل وعلم وقرب مقام من الإمام الخوئي، واحداً من أولئك الذين استمر بالعمل في هذه اللجنة لأكثر من خمسة وعشرين سنة، حتى آخر يوم من حياة المرجع الراحل (قدّس سِرُّه)، وكما هو المعروف فإن تلك اللجنة ضمت في فترات مختلفة أسماء علماء كبار ومجتهدين عظام تصدّوا لمقام المرجعيّة فيما بعد، أو هم في مقامها، من :أمثال السيّد مرتضى الخلخالي (قدّس سِرُّه)، والسيد علي البهشتي (قدّس سِرُّه)، والسيّد محمّد الروحاني (قدّس سِرُّه)، والشيخ ميرزا علي الغروي (قدّس سِرُّه)، والسيّد محمّد باقر الصدر (قدّس سِرُّه)، والشيخ ميرزا جواد التبريزي (قدّس سِرُّه)، والشيخ الوحيد الخراساني (دام ظلّه)، والسيّد تقي القمي، والشيخ ميرزا علي الفلسفي (قدّس سِرُّه)، والسيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) وغيرهم كثير من العلماء الأفاضل وكبار أساتذة الحوزات العلمية.
رغم الإلتزامات الكثيرة لشيخنا المرجع (دام ظله) فقد دأب سماحته على أن يفرغ بعضاً من وقته للتحقيق والتصنيف والتأليف، فقد ألف حتى يوم الناس الكتب التالية :
ص: 247
(محاضرات في أصول الفقه) في عشر مجلّدات، طبع خمسة منها وسيطبع الباقي إن شاء اللّه و(الأراضي) و (النظرة الخاطفة في الإجتهاد) و(تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى) طبع منها عشرة أجزاء و (أحكام البنوك) و(المباحث الأصولية) في 14 مجلد، طبع منها 9 مجلّدات، وستطبع باقي المجلّدات تباعا كما وعدت بذلك و (منهاج الصالحين) في ثلاثة مجلّدات و (مناسك الحج) و (مختصر مناسك الحج) و (توضيح المسائل) و (أجوبة المسائل الطبية) و (موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي) و (المختصر في الحياة العلمية) للسيّد الخوئي (قدّس سِرُّه) و (مائة سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات وجوابها) و (المسائل المستحدثة) و (بيانات وتوجيهات) و (الأنموذج في الحكومة الإسلامية) و (المختصر في أحكام العبادات) و (المختصر في أحكام المعاملات) بقسميه: الأول والثاني.
ومما يلفت النظر في اهتماماته المعرفية الأخرى أجوبته عن مسائل مستحدثة في أمور حياتية شتى، وخاصة في المجال الطبي لم تتناولها رسالته العملية، إضافة إلى تناوله بالبحث والتحقيق مسألتين في غاية الأهمية في وقتنا الحاضر: أولاهما في نظام الحكم الإسلامي، وثانيهما في موقع المرأة سياسيا.
تصدى المرجع الشيخ الفياض (دام ظلّه) للمرجعية الدينية بعد وفاة أستاذه ومعلمه المرجع الأعلى في وقته سماحة السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه)، وتصدى للإفتاء أسئلة المكلفين كما تصدى للشؤون العامة في سماع شكاوى المواطنين والإجابة عن ومشاكلهم، مع بذل ما في وسعه من جهد لتذليلها وحلها، ولطالما لمست منه (دام ظلّه) الحرص الشديد على إيصال صوته للمسؤولين حاثا وموجها وناصحا وعارضا الحلول ما أمكنه ذلك.
ص: 248
وللشيخ المرجع (دام ظلّه) مكتب يضم عدة أقسام تتولى مهمة تسيير شؤون مرجعية، فقسم للإجابة عن الإستفتاءات الواردة، وقسم لشؤون الطلبة يتولى توزيع الرواتب شهريا على الطلبة لما يزيد عن خمسة آلاف طالب علم، مع ملاحظة التمييز المعنوي والمادي بين الطلبة المشتغلين وغيرهم، كما يقوم هذا القسم بالإشراف على بحوث بعض الطلبة، وإبداء المشورة العلمية لهم وما إلى ذلك مما يقتضيه البحث العلمي العميق، وقسم لمتابعة شؤون مؤلفات الشيخ المرجع دام ظلّه) وتهيئتها للطبع، وقسم للعلاقات العامة، وقسم للانترنيت والكومبيوتر، وقسم للمكتبة والتصوير، وقسم للإدارة يضم من بين ما يضم لجنة متخصصة لتنسيب ومتابعة شؤون وكلاء مرجعية الشيخ (دام ظلّه) ومأذونيه الذين يقدر عددهم حتى هذه السنة بحوالي مائة وعشرة بين وكيل ومأذون داخل العراق وخمسة وثلاثين خارج العراق يتولون مهمة نشر الوعي الديني والفكري والأخلاقي والعقائدي في الأماكن التي يعملون بها معظمهم من طلبة العلوم الدينية(1). ينظر الملحق العاشر).
ص: 249
ص: 250
يتناول هذا المبحث مطالب عدة هي:
هو المرجع الحافظ الشيخ بشير حسين بن صادق علي بن محمد إبراهيم بن عبد اللّه اللاهوري، واسمه (بشير حسين) من مَركبات الأسماء، ولكن شاع مختصراً باسم (الشيخ بشير).
ولد (دام ظلّه) عام (1361 ه/ 1942م) في مدينة (جالندهر) إحدى كبريات مدن الهند، في ظل أسرة لها مكانة اجتماعية ملحوظة في بلادها لاهور - فجده لأبيه الشيخ محمد إبراهيم، كان شخصية علمية واجتماعية وسياسية، كما كان زعيم عشيرته ومرجعهم في الحلِ والعَقْد، وممّا نقلهُ الثِقات أنهُ كان لجده ديوانٌ عامر ومجلس كبير يؤمه الناس على اختلاف وتبايُن نحلِهِم ومللهم، وكانت تجري فيه المناظرات والمناقشات العلمية بين جدّ المرجع النجفي (دام ظلّه) وأرباب المذاهب الإسلامية من جهة، وبينه وبين الهندوس- وهم كثر في وطنه من جهة أخرى.
أما والده الشيخ صادق علي فهو الآخر من وجهاء مدينته، فقد سار على نهج أبيه بعد وفاته فكان شخصية اجتماعية وصاحب دیوان عامر يرتاده الناس من مختلف
ص: 251
طبقات المجتمع، وتجري فيه المناظرات مع أبناء الفرق الإسلامية الأخرى حيث كان هو القائم عليها والمدير لها، ودفن أبوا الشيخ المرجع حيث توفيا.
دأب الفتى (بشير حسين) في بداية تحصيله العلمي على دراسة مُقدّمات العلوم المعروفة من نحو وصرف وبلاغة وفقه وأصول في مدينة لاهور على يد جدّه لأبيه الشيخ محمد إبراهيم الباكستاني - المتقدم ذكره - وعمه الشيخ خادم حسين الباكستاني، والعلامة الشيخ أختر عباس الباكستاني مؤسس (مدرسة جامع المنتظر) الدينية، وهي من أكبر وأنشط المدارس الدينية في باكستان حالياً من حيث كفاءة الأساتذة وطموح الطلبة في تحصيل المراتب الراقية في العلوم الشرعية.
ومن أساتذته في بلده أيضاً شريف العلماء السيد رياض حسين النقوي، والمرحوم الفاضل السيد صفدر حسين النجفي.
ثم هاجر الشيخ بشير في حدود (سنة 1385 ه/ 1965م) إلى النجف الأشرف حاضرة العلم الكبرى ومعقل الدراسات الإسلامية الراقية، للانتهال من ينابيع العلم والتشرّف بمجاورة إمام المتقين باب علم مدينة رسول اللّه صلوات اللّه وسلامه عليهما وعلى آلهما الطاهرين، وما أنْ قرتْ عينه بالنزول في تلك العراص الطاهرة حتى بادر إلى الدراسة على مشايخ العلم المعروفين يؤمئذ من أمثال الشيخ محمد كاظم التبريزي (طاب ثراه) وقد درس عنده (الكفاية) في مدرسة المرجع الشيخ الشربياني (قدّس سِرُّه)، كما حضر بحوث المرجع المرحوم السيد محمد الروحاني (قدّس سِرُّه) أصولاً وفقهاً لأكثر من سبع سنوات.
ولما آنس (دام ظلّه) من نفسه القدرة على التدريس شرع بتدريس السطوح عام
ص: 252
(1388ه/ 1968م) في (المدرسة المهدية) الواقعة خلف جامع الطوسي، وفي (المدرسة الشبرية)، وفي (مسجد الهندي)، وإذ اكتملت لديه القدرة العلمية على حضور البحث الخارج دأب على حضور بحوث خارج الفقه والأصول عند المرجع الأعلى في وقته سماحة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه) حيث درس عنده دورة كاملة ملفقة. في الأصول، وسنوات بحث طويلة في الفقه استمرت لحين انقطاع المرجع الأعلى السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) عن التدريس بسبب التدريس بسبب حالته الصحية.
ونظرا لِما يتمتع به المرجع الشيخ المترجم له منْ مكانة علمية فقد أحبَّ التدريس فأكثر منه ابتداءً من (جامعة المنتظر) في باكستان إلى يومنا هذا في مختلف الفنون والمستويات، فهو منذ خمسة وثلاثين عاماً أي من عام (1393 ه/ 1974م) يباشر بإلقاء دروسه الأولية والعالية سواء ما كان منها في (مدرسة دار الحكمة) التي أسسها المرجع الأعلى في وقته سماحة السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) أم في (مدرسة دار العلم) التي أسسها المرجع الأعلى في وقته سماحة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه) – وقد فجرهما أتباع النظام البائد بقنابل الديناميت وصادر كتبها خلال استباحته مدينة النجف الأشرف عام (1411 ه / 1991 م ) - أم في (المدرسة الشبرية) أم في (مدرسة القوام) المسامتة لمسجد شيخ الطائفة الطوسي (قدّس سِرُّه) أم في (مسجد كاشف الغطاء) أم في المسجد الهندي أكبر أماكن الدراسات الحوزوية في النجف الأشرف كما تقدم، وما زال (دام ظلّه) يواصل تدريسه خارجاً في الفقه والأصول والتفسير والأخلاق إنما في داره في منطقة الجديدة في النجف الأشرف (ينظر الملحق التاسع).
هذا يروي سماحته في علم الحديث: الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة (رضوان اللّه عليهم) وهي: كتب : (الكافي)، و(الفقيه)، و(التهذيب)، و(الاستبصار) ويروي أيضا: (سائر مؤلفات الشيخ الصدوق)، و (شيخ الطائفة الطوسي)، و(العلامة الحلي)، يرويها
ص: 253
بسندٍ متصل إلى إجازة (العلامة) الكبيرة المطبوعة، وقد استجازه جملة من الأفاضل فمنح لهم الأجازة بذلك.
ينقل فضلاء تلامذته وأجلاء حُضّار بحثه أن المرجع الشيخ بشير النجفي (دام ظلّه) يتميز بطريقة تدريس تمتلك قوّة بيان وحسن تبويب للمطالب، وسلامة ترتيب للمقدمات المفضية إلى النتائج، مع الابتعاد عن الحشو والفضول وتقريب المعنى البعيد باللفظ الوجيز البعيد عن الاحتمال والاشتراك.
وقد ذكر غير واحد من تلامذته ان الشيخ المترجم له يستحضر المسائل المبحوثة في المقدمات والسطوح إلى أرقى دروس بحث الخارج في النحو والصرف والمنطق والأصول والفقه وغيرها وكأنه راجعها قبل قليل، كما ذكروا عنه أنه يسعى بجد لتمكين تلامذته من هضم مستصعبات المسائل بالترويض والمزاولة وإعادة الترويض والمزاولة وصولا نحو الهدف المنشود، وقد اشار إلى ذلك والى أمور تخص العملية التربوية في رسالته التي وجهها إلى طلبة الحوزات العلمية، آثرت أن أثبتها كونها تلقي الضوء على ما أحببت أن ألقي الضوء عليه من منهجه في التربية والتعليم، فقد جاء فيها بعد حمد اللّه والثناء عليه والصلاة على نبيه الكريم محمد وآله الطيبين الطاهرين قوله :
ابعث رسالتي هذه من النجف الاشرف وأجدني مشاركاً روحاً وقلباً مع هذه الأفئدة التي تجمعها هذه المدارس والمراكز العلمية صانها اللّه من ريب الدهور على اختلاف أصنافها من الأجلاء وطلبتنا الأعزاء على اختلاف طبائعهم واجتمعت نفوسهم فيها على العزم والالتزام بسعي حثيث في الارتواء بمنهل علم أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).
اعلموا أيها الإخوة الفضلاء وأولادي الأتقياء الأعزاء أن رابطة الدين أقوى من
ص: 254
كل الروابط، فإنّ هذا الرابط دفع أولئك الذين سبقونا بالإيمان إلى نبذ كل العلاقات النسبية والسببية والعشائرية وإلغاء كل الاعتبارات التي تقتضي تصنيف البشرية، فكان الرابط الديني أقوى وأسمى وأكثر تأثيراً وأعظم مفعولاً في نفوسهم، فوتروا الأقربين والأبعدين في ذات اللّه، فرابط الدين لابدَّ وان يكون فوق كل الاعتبارات.
وهنا رابط آخر نشترك كلنا فيه، وهو رابط العلم، فقد جمعتنا هاتان الرابطتان فكلنا رواد هذا المنهل الروي مشرع علم الدين، فعلينا جميعاً الاهتمام بالأمور التالية:
الأمر الأول: نجد انه قد أصاب الحوزات العلمية الوهن من حيث الكتب، فنجد طلابنا الأعزاء مَيّالين إلى الكتب السهلة والدراسة السطحية بما يجعلنا نتوقف اتجاهه ملياً، لأنه إذا استمر. لا سمح اللّه فهو لا يبشر بخير.
أخوتي الأجلاء قد بلغني - وأنا في النجف الأشرف - شدة الاهتمام بالحوزات العلمية التي تترأسها سائر الفرق الإسلامية، ولاسيما الوهابية بحيث ينذر ذلك بالخطر الداهم على البلاد الإسلامية، وعلينا التيقظ والالتفات إلى ما نحن فيه، والسعي إلى إرجاع طلابنا الأعزاء إلى سابق العهد الذي عهدنا السلف الصالح من علمائنا الأبرار عليه، فلتكن الدقة والتعمق والتوجه إلى الكتب الصعبة في كل الفنون مقصدنا جميعاً، وعلى المدرسين الأفاضل الاهتمام بهذا الموضوع.
الأمر الثاني: انه بلغني أنَّ كثيراً من الطلبة يخلط بين المنهج الدراسي المتبع في الحوزات العلمية وبين المناهج الدراسية السائدة في الكليات والجامعات التي ترعاها الحكومات في شتى إرجاء العالم فحيث يرون أن الكتب المطروحة أمام الطلبة في تلكم الكليات والجامعات يقصد في أثناء تأليفها التبسيط والتسهيل في التعبير بينما الكتب المطروحة سابقاً في الحوزات العلمية معقدة في تعبيراتها ومستعصية على فهم الطالب العادي
ص: 255
فيتصور بعضهم انه ينبغي أن تكون الكتب الرائجة في الحوزات العلمية شبيهة بالسائدة في الكليات والجامعات ولكنه بأدنى التفاتة يتضح انه لا ينبغي الخلط بين المنهجين، والسر في ذلك إن الغاية من الدرس والتدريس في الكليات والجامعات إعداد الطالب فيها لفهم وإدراك ما وصل إليه العلماء في العلوم الجديدة والفنون الحديثة والإحاطة بها، ومن ثم مواصلة السير في تطوير تلك العلوم والفنون في المستقبل والاستفادة منها ولا علاقة للطلاب بالتعبيرات التي استخدمت وبالألفاظ أو اللغات التي استعان بها العلماء السابقون في تلك العلوم الحديثة، وبما أن طريقة التعبير وسليقة التكلم بكل لغة تتغير وتتبدل بمرور الزمن فربما يكون تعبير واضحاً وسلساً في زمان وبعد مدة يصبح للأجيال القادمة مُعقداً يفتقر الناظر فيه إلى القواميس والاستعانة بقواعد اللغة على الوصول إلى مغزى الكلمات المستخدمة للكشف عما في ضمير المتكلم، مثلاً الخطب التي ألقيت قبل قرون على عامة الناس نجدها اليوم معقدة وبعيدة عن سليقة التكلم وطريقة التعبير التي نعايشها، ومن هنا نجد الحكومات المهتمة بالمدارس والكليات تضطر إلى تغيير الكتب الدراسية بين فترة وأخرى.
بينما طالب علم الدين تنحصر وظيفته وينصب اهتمامه في فهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والروايات المروية عن أئمة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وهي صدرت من متكلميها قبل قرون، وكانت واضحة سهلة الفهم في حينها، ولذلك تم التحدي بتلك الآيات الشريفة لكل من بلغه القرآن في حينه مع سيطرة الأمية على الناس.
وكذلك الأحاديث النبوية وخطب أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأدعية الصحيفة السجادية وغيرها مثل دعاء سيد الشهداء (عَلَيهِ السَّلَامُ) يوم عرفة، فإنها كلها ألقيت وقُرِئَتْ على عامة من يعرف اللغة العربية وكانوا يفهمونها ويستوعبون أدق معانيها لوحدة السليقة في التعبير بين المتكلم والمخاطب، والآن لأجل البعد الزمني الهائل والتبدل الواضح بين
ص: 256
سليقة التعبير في ذلك الوقت وسلوك التعبير اليوم فلا نتمكن من فهم تلك النصوص لمجرد تمكننا من التحدّث باللغة العربية السائدة اليوم وفهمها، فلابد من ترويض ذهن الطالب وتمرينه بنحو يتمكن من فهم واستيعاب المعاني العميقة التي اشتملت عليها تلك التعبيرات.
ولو تعوّد الطالب على التعبيرات السهلة والطرق التعبيرية التي استأنست أذهننا بها وتعوّدت نفوسنا عليها لبقي بعيداً عن عموم تلك المعاني، فيجب الاهتمام بالكتب المعقدة والتعبيرات التي سعى علمائنا الأبرار إلى تبنيها في مقام إيصال المعاني العالية والمطالب السامية وإيصالها للأجيال اللاحقة.
الأمر الثالث: الاهتمام بمظهر طالب العلم بأن لا يخرج عن زي رجل الدين، فالتزي بالزي الأوربي والتمادي في تبني المظاهر المجلوبة من الأغيار في شعر الرأس والملابس والأحذية وطرق الأكل والشرب بنحو ما أخذ يسود في البلاد الإسلامية مما لا ينبغي أن يحدث في الحوزات العلمية.
إن الاهتمام بالمظهر أمر ضروري، والتخلي عن الزي التقليدي لرجل الدين... يؤمي إلى الإحساس بالنقص في الطالب، فإنا لا نجد أحداً من أعداء الإسلام يفكر في التخلي عن سلوكه في المأكل والملبس، بينما نجد شبابنا وأفلاذنا مندفعين إلى التخلي عن سلوكنا في الحياة وتبني سلوك الأوربيين.
الأمر الرابع: الاهتمام بالجانب الروحي، وينبغي أن لا يذهب علينا أن مجرد حفظ القواعد اللغوية العربية وغيرها والإحاطة بالمسائل الفلسفية والكلامية والأصولية ونحوها وحده لا يقرب الطالب إلى اللّه سبحانه بل لا يجعله في صف طلبة علم الدين بالمعنى الواقعي فإنَّ تعلم المسائل بل التبحر فيها مقدمة لصياغة النفس في قالب الدين،
ص: 257
فيجب على المهتمين بتربية طلابنا الأعزاء مراقبة سلوك الطالب وحثه على الالتزام بتقوى اللّه والخشية منه في السر والعلانية، ويجب أن يرافق الارتقاءُ الروحي التقدمَ العلمي، وأن يواكب السمو النفسي الارتفاع في مدارج العلوم التي يدرسها في الحوزات حتى يتجسد الدين في حركاته وسكناته فيكون مثالاً يحتذي به الناس.
الأمر الخامس : يجب توجيه القسط الكبير من الاهتمام إلى تهذيب النفس وحسن السلوك فإنّ تحسين التعامل مع الآخرين على أساس المساواة انطلاقاً من مبدأ: حب لأخيك ما تحب لنفسك من سمات عامة المؤمنين، وأما الذي أوقفَ نفسه في صفوف طلاب علم الدين طمعاً في أن يوفقه اللّه للانخراط في سلك علماء الدين ليحظى بالمقام في حظيرة القدس في زمرة القديسين الصديقين وفي جوار صاحب المقام المحمود النبي الأعظم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)عند مليك مقتدر، والذي يرجو ذلك من العلي القدير فإنَّه يجب أن يكون من المؤثرين للآخرين على نفسه رغم الخصاصة.
كما أن التواضع للعلم والعلماء وجعل النفس دائماً في قفص الاتهام والحكم عليها بالقصور بل بالتقصير تجاه الآخرين تُعتبر الخطوة الأولى في سبيل إصلاحها فإنَّ تهذيب النفس الذي دعا إليه وسعى فيه الحكماء والمصلحون من أهم الواجبات فإنّ صلاح خلق الفرد أساس إصلاح المجتمع.
فإذن أيها الطالب العزيز ليكن قيامك وقعودك وتعاملك مع الآخرين على أساس الإيثار.
أرجو اللّه سبحانه أن يمكننا جميعاً من إصلاح نفوسنا وأداء ما علينا وان يحلينا بالعلم والعمل ويجعلنا من شيعة ولي اللّه الأعظم أرواحنا لمقدمه الفداء انه رحيم ودود.
ص: 258
كتب المرجع الشيخ (دام ظلّه) في علوم مختلفة منها في الفقه والأصول والفلسفة والكلام والتفسير والحديث والمسائل المستحدثة وغيرها أهمها: (الدين القيم رسالته العملية في العبادات ومعاملات - في ثلاثة أجزاء مطبوع)، وقد تُرجمت إلى الانكليزية والأوردية والكجراتية، و(وقفة مع مقلدي الموتى: مطبوع)، و (مرْقاة الأصول: مطبوع)، و(مناسك الحج،مطبوع)، و (خير الصحائف في أحكام العفاف مطبوع)، و(مائة سؤال حول الخمس: مطبوع)، و(هداية الناشئة : مطبوع)، و ( أعمال وأحكام شهر رمضان المبارك: مطبوع)، و (ستبقى النجف رائدة حوزات العالم مطبوع)، و(الخريت العتيد في أحكام التقليد: مطبوع)، و (مصطفى الدين القيم : مطبوع)، و (المرشد الشفيق إلى حج البيت العتيق: مطبوع)، و(المنهل العذب لمن هو مغترب : مطبوع)، و(بحوث فقهية معاصرة: (مطبوع)، و (الشعائر الحسينية ومراسيم العزاء : مطبوع)، و(ولادة الإمام المهد (عَجَّلَ اللّهُ تَعَالَي فَرَجَهُ الشَریف) ي مطبوع)، و (مختصر الأحكام، مطبوع بلغة الأوردو)، و (إلى الشباب: مطبوع)، و(التائب حبيب اللّه : مطبوع).
ولديه (دام ظلّه) عدة كتب مخطوطة بعضها مكتمل التأليف وبعضها لا يزال غير مكتمل عسى أن ترى النور قريباً.
تصدى المرجع المترجم له للمرجعية الدينية بعد وفاة أستاذه المرجع الأعلى في عصره سماحة السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه) في عام 1992م.
وله مشاريع عدة اضطلع بها سماحته سبق أن ذكرها الشيخ صادق سليم المحسن في رسالته عن أحوال سماحة الشيخ (دام ظله) منها : قيامه بإعادة طبع الكتب الدراسية
ص: 259
المعروفة في المنهج الحوزوي من كتب النحو والبلاغة والصرف والمنطق والكلام والفقه وأصوله. ومنها عدم التسامح بما يسمى ب(الطفرة) في سلم الدراسات المنهجية أو التحايل والتهرب عن أداء الامتحانات الشهرية.
ومنها : الاهتمام بشؤون الفقراء وأهل الحاجة وذلك بتعيين الرواتب الشهرية لهم وتوفير العلاج الطبي وإمدادهم بالملابس الصيفية والشتوية والأدوية وسائر ما يتمكن منه من مور المتوفرة عنده مما يتلقاه من مقلديه ومريديه.
ومنها أنه لا يجيز لمعظم الطلبة والمبتدئين خاصة أن يغادروا النجف الاشرف حتى لمثل التبليغ بغية حثهم على المواظبة على الدرس والبحث.
ومنها نصب مولدات للطاقة الكهربائية وتوزيع خطوط الكهرباء للعوائل وللمدارس والمدارس الدينية والجوامع والحسينيات وبفضل اللّه فقد وصلت أعداد المستفيدين منها إلى ما يقارب 3000 آلاف بيت.
ومنها: إقامة مدارس نموذجية رسمية خاصة للأيتام باسم: (مدارس دار الزهراء (عَلَيهَا السَّلَامُ) للبنين)، و (مدارس دار الزهراء (عَلَيهِا السَّلَامُ) للبنات) امتازت هذه المدارس بتقديم رعاية متطورة للأطفال الأيتام، مع تقديم مساعدات شهرية ودورية لهم. ومنها الاهتمام بجلب طلاب العلوم الدينية من بلدان مثل اليمن وأفغانستان وباكستان والخليج والهند لأجل الدراسة في النجف الأشرف وغيرها.
تعرض سماحة المرجع الشيخ بشير النجفي (دام ظلّه) لمحاولة اغتيال بالقنابل اليدوية ليلة الجمعة إحدى ليالي القدر المباركة من عام (1419 ه/ 1998م)، وهو جالس في ركن مكتبه يؤدي واجبه الديني كمرجع، الّا أن اللّه سلّم واستنقذه من غرفة امتلأت
ص: 260
بشظايا ونيران القنابل والقتلى والجرحى ليواصل مسيرته لخدمة دین الله القويم.(1)(ينظر الملحق العاشر).
ص: 261
ص: 262
(1) قاعدة لا ضرر ولا ضرار. تقريرات السيد السيستاني. بقلم السيد محمد رضا السيستاني : أنظر هوامش الصفحات: 82 و 89 و 91 و 92 و 99 و 107 و 174 وغيرها
(2) المصدر السابق : أنظر هامش : 330
(3) الرافد في علم الأصول. تقريرات السيد السيستاني. بقلم السيد الخباز :
(4) نفسه
(5) نفسه : 88
(6) سورة الزمر : آية رقم: 1
(7) أساطين المرجعية العليا في النجف. سابق : 95
(8) ينظر : موقع المرجع الأعلى السيد السيستاني على الانترنيت.
(9) ينظر : موقع المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم على الانترنيت.
(10) ينظر : موقع المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض على الانترنيت.
(11) ينظر : موقع المرجع الشيخ بشير النجفي على الانترنيت.
ص: 263
ص: 264
ويتناول هذا الفصل مباحث أربعة هي :
المبحث الأول : الأعداد التقريبية لطلاب الحوزة العلمية سابقا وحاليا.
المبحث الثاني : أماكن دراسة طلاب الحوزة العلمية.
المبحث الثالث: الأقسام الداخلية للطلاب سابقا وحاليا.
المبحث الرابع: برنامج يوم عمل لطلاب في حوزة النجف الأشرف.
ص: 265
ص: 266
تفاوتت أعداد طلاب الحوزة العلمية في النجف بين مد وجزر تبعاً للظروف
السياسية المعقدة في العراق، فحين تخفف السلطة وأجهزتها القمعية ضغوطها على الحوزة تنمو أعدادها،باطراد وحين تتصاعد ضغوط الأمن والمخابرات وأجهزة الحزب تبدأ أعدادها بالتناقص. وحين أقول ضغوط السلطة لا أعني بذلك الضغط الذي يتحمل ويمكن ولو برباطة الجأش تصريفه فذلك ما اعتادت عليه الحوزة وتكيف له مراجعها وطلابها وأساتذتها، وإنما أعني بذلك تلك الضغوط الشديدة غير القابلة للتحمل من أمثال عدم السماح للراغبين الجدد من غير العراقيين بالدخول إلى البلد للالتحاق بالحوزة العلمية النجفية، ووجبات التسفير الإجباري وحملات الإيذاء المنظم والدهم والتفتيش والترويع والتخويف والتهديد وموجات السجن والاعتقال الكيفي وصولا إلى الإعدامات والقتل الجماعي من دون محاكمة أو تحقيق كما حصل في الانتفاضة الشعبانية عام (1411ه/1991م) وما سبق الانتفاضة الشعبانية ومقابرها الجماعية وما لحق عذاباتها وأشجانها الكثير الكثير.
وتقدر بعض المصادر عدد الطلبة في النجف في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف طالب (1) بل ونقلت رسالة وردت لمجلة المنار المصرية الصادرة في القاهرة سنة (1326 ه/ 1908م) نشرتها تحت عنوان:
ص: 267
(كلمات عن العراق وأهله لعالم غيور على الدولة ومذهب أهل السنة)، تعرض فيها كاتبها للتنديد بشيعة العراق الذين بلغ عددهم كما يقول الكاتب ثلاثة أرباع العراقيين، محرضا الدولة العثمانية عليهم، وقد عقّب عليها بقبول ما فيها وتأييده لها رئيس تحرير مجلة المنار الشيخ محمد رشيد رضا، وقد جاء فيها مع الأسف من جملة ما جاء فيها ما نصه: وفي النجف مجتمع مجتهدي الشيعة، وفيه من طلبة العلوم ستة عشر ألفا، ودأبهم انهم ينتشرون في البلاد، ويجدون في إضلال العباد(1).
ويدعم هذا التقدير ما ورد عن بعض المطلعين من أن عدد طلاب العلوم الدينية قبل الحرب العظمى الأولى وفي أيام الملا محمد كاظم الآخوند (الخراساني) لا يقل عن عشرة آلاف طالب (2)، بل نقل عن بعضهم أن العدد لا يقل عن اثني عشر ألفا(3).
ويبدو أن العدد يفوق ذلك، فقد نقل عن الشيخ أغا بزرك الطهراني(4) قوله: وقد سمعت ممن أحصى تلاميذ الأستاذ الأعظم المولى محمد كاظم الخراساني في الدورة الأخيرة في بعض الليالي بعد الفراغ من الدرس أنه زادت عدتهم على الألفين والمائتين، وكان الكثير منهم يكتب تقريراته وجمع منهم كانوا أصدقائي، ورايت تقريراتهم الكثيرة في الكراريس والمجلدات، وتوجد تقريرات كثيرة لم يشخص مقررها.
ونقل عن المرجع الشيخ ضياء الدين العراقي(5) (1364 ه/ 1945م) من أكابر تلاميذ المرجع الشيخ محمد كاظم الخراساني بأن عدد طلاب البحث الخارج للشيخ تعدى في فترة من الفترات 1700 نفر في الليلة. ونقل مثله عن الميرزا محمد الفيض باشتراكه مع المرجع العراقي(6).
بل ورد عن الشيخ علي الشرقي قوله :(7) وكان يحف بمنبره ثلاثة آلاف طالب منهم المجتهد أو المرشح للاجتهاد.
ص: 268
إن هذا العدد الكبير من طلاب البحث الخارج ومن كتاب التقريرات زمن الشيخ الخراساني يكشف عن أن أعداد طلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف تلك الآونة سواء منهم من كان من طلاب البحث الخارج من غير حضار بحث الشيخ الخراساني أم من كان منهم في المستويات الأدنى من طلاب البحث الخارج كطلاب مرحلة السطوح أو طلاب مرحلة المقدمات يفوق العدد المقدر لهم فيما تقدم بكثير.
بيد أن هذا العدد الكبير قد انخفض كثيرا أيام الحرب العالمية الأولى جرّاء الحرب. ثم عاد للارتفاع تدريجيا حتى عهد حكومة عبد المحسن السعدون حيث بدأ بالانخفاض سريعا بعد أن أقدم رئيس الوزراء خلال سنة (1342 ه/ 1924م) على نفي أكابر مراجع الحوزة العلمية في النجف وعلمائها المعارضين لنهجه في الحكم إلى خارج العراق، ثم عادت أعداد طلاب الحوزة إلى الارتفاع تدريجيا بعد مطلع الثلاثينات إثر تقلد المرجع السيد أبو الحسن الأصفهاني المتوفى سنة (1364 ه/ 1945م) والعائد من منفاه القسري زعامة المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.
وما أن حلّ شهر ديسمبر كانون الأول من عام ( 1376 ه / 1957م) حتى بلغ عدد طلابها بحدود ألفي طالب، وهو ما أثبتته لحسن الحظ إحصائية أجراها الباحث الدكتور فاضل الجمالي المتخصص بعلوم التربية ورئيس وزراء العراق عامي 1953 و 1954م والمولع منذ (عام 1345 ه/ 1927م) بحب البحث عن الدراسة ونظمها في النجف الأشرف يقول الدكتور الجمالي في بحثه المعنون جامعة النجف الدينية الذي ألقاه في المجلس الثقافي البريطاني ببغداد (عام 1376 ه/ 1957م) مانصه ومنذ ثلاثين عاما على وجه التقريب كان كاتب هذه السطور قد غاص في الدراسة وطرق التدريس لإظهار تفرد النظام الدراسي في النجف وأهميته وكان ذلك جزءا من بحث للدكتوراه يتناول: (النظام الدراسي في جامعة النجف) إلّا أن المقترح تبدل لعنوان آخر(1).
ص: 269
ولم يبرد ولعه بحب البحث عن جامعة النجف فقد زار النجف الأشرف في شهر تشرين الأول من (عام 1376 ه/ 1957م) ومكث في ربوعها أسبوعا باحثا بحثا ميدانيا عن جامعة النجف الدينية وأنظمتها التربوية ليخلص من دراسته إلى أن التركيبة الإحصائية لعدد الطلاب في النجف في شهر ديسمبر 1957 هي كالآتي:
الطلبة الإيرانيون : 896
الطلبة العراقيون 326
الطلبة الباكستانيون: 324
الطلبة من التبت: 270
الطلبة الهنود : 71
الطلبة السوريون واللبنانيون : 47
الطلبة البحرانيون (البحرينيون) والقطيفيون : 20
المجموع الكلي هو (1954) طالباً. وهذا العدد يختلف باختلاف فصول السنة والظروف(1).
ثم استمرت بعد ذلك أعداد الحوزة العلمية في النجف الأشرف تتزايد باطراد حتى وصلت إلى ما يقرب من عشرة آلاف طالب في فترة ما من فترات مرجعية الإمام السيد محسن الحكيم المتوفى عام (1390 ه/1970م)، فقد تمكن سماحته (قدّس سِرُّه) خلال عشر سنوات أن يرفع عدد العلماء وطلاب العلوم الدينية في النجف الأشرف من (1500) إلى أكثر من (7000) طالب وهذه نسبة هائلة كما نلاحظ تصل إلى حوالي (500 ٪) في هذه الفترة وهي نسبة قياسية في حركتنا الحوزوية العلمية في تاريخنا المعاصر.
ص: 270
إن الحوزة لو كانت سائرة بنفس المنهاج الذي سارت فيه أيام مرجعية الإمام الحكيم قبل مجيء النظام البائد لكان من الممكن أن يصل عددها إلى أربعين ألف دارس و مدرس، وكان من الممكن أن يتطور الجانب الكيفي بهذا المستوى وبهذا الشكل(1) ولعل الحد من هذا النمو الكبير في الحوزة العلمية والخشية من إمكانية التسارع في تطورها الكيفي ورصد تأثيرات هذا النمو المحتملة على الوضعين الداخلي والإقليمي والخارجي كان سبباً من بين أسباب أخرى أدّت إلى تكالب الأنظمة الطائفية في العراق بتشجيع ودعم إقليمي وخارجي كبير والسعي إلى تفكيك هذه المؤسسة العلمية والإسلامية قدر الإمكان بشتى الوسائل ابتداء من التصفيات الجسدية إلى الاعتقالات إلى التسفير الجماعي إلى غيره مما هو معروف و مشهور (ينظر الملحق الحادي عشر).
ومع تزايد الضغوط الأمنية على الحوزة بدأت أعدادها بالتناقص تدريجيا وبخاصة من غير العراقيين، فقد وجدت ما يشير إلى أنها كانت بحدود ( 8000 أو. 10000 طالب) في بداية الثمانينات، وهو ما ورد في تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المستر ماكس فان شتويل، ثم تناقص عدد طلاب الحوزة كثيرا فوصل إلى ما يقدر ب (2000 طالب) بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ أي في بداية التسعينات، ثم استمر العدد يتناقص تدريجيا نتيجة الظروف القاسية كما سيأتي حتى وصل إلى حدود (800 طالب) فقط قبل الانتفاضة الشعبانية عام (1411 ه/ 1991م)، بل أقل من ذلك كثيرا حين اندلاعها.
بيد أن مؤشرات تنامي العدد بعد سقوط نظام الدكتاتور عام (1424 ه/ 2003م) بدأت بالتصاعد تدريجيا بعد زوال الخوف المرعب من القتل والسجن والأذى والتشريد والتسفير والمقابر الجماعية ليبلغ في (عام 1426ه/2005م) إلى ما يزيد عن (3500 / طالب)، عدا المبتدئين حاليا بالدراسة، من الطلاب والطالبات اللواتي بدأت تنشط
ص: 271
حلقاتهن الدراسية الحوزوية نشاطا ملفتا للنظر، بل متميزا.
أما في عام (1433 ه/ 2012م) فقد وصلت أعداد الحوزويين إلى ما يناهز تسعة آلاف أستاذ وأستاذة، وطالب وطالبة، بينهم - عدا المراجع العظام - العشرات من أساتذة (البحث الخارج) و(السطوح العالية الكفاية والمكاسب)، وفقهم اللّه لكل خير، ونفع بهم إنه خير مسؤول ومرجو (ينظر الملحق الثاني عشر)
إن عدد طلاب حوزة النجف الأشرف مرشح للصعود خلال الأعوام المقبلة كما أتوقع إن تهيأت لهم مدارس أو أماكن لسكنهم، وهي مشكلة طالما عانى منها طلبة الحوزة ولا زالت بحاجة إلى حل جذري، وإن لم يطرأ على وضعهم الأمني – وهو الأهم- طاريء يهدد دراستهم وتدريسهم، بل وجودهم وحياتهم بالخطر الشديد، وهو ما أسأل اللّه أن لا يكون، وأبتهل اليه أن يبعد شر التكفيريين ومن لفّ لَفَهُم عنهم وعن العراق وأهله المؤمنين إنه سميع مجيب.
هذا وهناك حوزات دينية أخرى رجالية ونسائية بدأت تنشط في محافظات العراق ومدنه وأقضيته وقصباته المختلفة، لم أتطرق اليها كونها خارج نطاق هذا البحث الخاص بحوزة النجف الأشرف، عسى أن أوفق في فترة أخرى لدراستها دراسة ميدانية، لما لذلك من أهمية حالية ومستقبلية على صعيد الواقع العراقي الداخلي والعربي والإسلامي.
ص: 272
تتوزع أماكن دراسة طلاب الحوزة عادة وتتنوع بين أماكن عدة يأتي في مقدمتها الصحن الحيدري الشريف لما يضفيه جوه الروحي على الطالب والأستاذ والدرس من دفء في البصيرة مميز وتفتتح على الاستيعاب العلمي مشهود.
وقد عاد الصحن الحيدري الشريف لاحتضان دروس أساتذة الحوزة العلمية في (حسينية المدرسة الغروية) بداية هذا العام (ينظر الملحق الثالث عشر) أو في بعض غرفه التي ضمت أجداث كبار علمائها (ينظر الملحق الرابع عشر)، وبدأت أجواء الصحن الشريف تتعاهدها الدروس العالية لعلوم النحو العربي والفقه وأصوله ضاجة بالحوارات العلمية منذ الصباح الباكر من كل يوم دراسي وحتى الظهيرة.
وقد عمر الصحن الحيدري الشريف بالعدد الغفير من الطلبة والباحثين وبخاصة في فترات الضيق والشدة والعوز المادي ففي القرن التاسع عشر مثلا كانت الأوضاع الاقتصادية في العراق بشكل عام وفي المدن الشيعية بشكل خاص سيئة للغاية بسبب كون العراق بؤرة صراع في تلك الفترة من ناحية، ومن ناحية أخرى أكثر تأثيرا بسبب وجود الحكومة السنّية العثمانية، فكانت هذه المناطق من أكثر مناطق الدولة العثمانية تردیا اقتصاديا، ومن أكثرها إهمالا، هذا كله من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الحوزة العلمية نفسها كانت تعيش أوضاعا اقتصادية سيئة وبالتالي فلم يكن من اليسير على الحوزة بناء مدارس تقام فيها الدروس فكانت تستخدم هذه الصحون الشاسعة مراكز
ص: 273
للتدريس(1).
فمن غرف الصحن الشريف وأواوينه الأربعة والأربعين وأكثرها ارتيادا منهم إيوان السيد الحبوبي وإيوان السيد اليزدي إلى الجوامع وقد تجاوزت في المحلات القديمة وحدها من النجف الأشرف الثمانين مسجداً وجامعاً، ولعل من أقدم هذه الجوامع التي اتخذت مراكز للعلم والبحث والمحاضرة جامع (عمران بن شاهين) الذي شيد في أواسط القرن الرابع الهجري ولا زال مكانا للبحث والتدريس، وقد كنت أشاهد فيه مرارا المرجع الأعلى في وقته سماحة السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) المتوفى عام (1390 ه/ (1970م) يلقي فيه أبحاثه العليا على طلبته، ولا زال المسجد عامرا بالبحث والتحصيل العلمي (ينظر الملحق الخامس عشر)، ومن الجوامع المهمة أيضا جامع (الخضراء) وهو من المساجد القديمة البعيدة،العهد، وقد كنت أشاهد المرجع الأعلى في حينه سماحة السيد الخوئي قتل المتوفى عام (1412ه / 1992م) مرارا يلقي فيه أبحاثه، ثم استمر من بعده المرجع الأعلى اليوم السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) يحاضر فيه حتى أغلقته سلطات العهد الدكتاتوري الصدامي الظالمة بحجة التعمير فقطع سماحته مجبراً تدريسه فيه.
وبعد سقوط النظام البائد اعيد تعمير جامع الخضراء والحقت به مقبرة لسماحة المرجع ألأعلى السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) واعاد الجامع يحفل بطلاب الحوزة العلمية يدرسون فيه ويتدارسون (ينظر الملحق السادس عشر).
ومن الجوامع الشهيرة بالبحث والمناظرة كذلك جامع (الشيخ الطوسي)، وكانت داراً لشيخ الطائفة الطوسي عندما هاجر إلى النجف عام (448 ه/ 1056 م) ومنتدى للعلماء والدارسين في زمانه وقد كان المرجع الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني يلقي بحوثه الغاصة بالطلاب على سطحه لسعته.
ص: 274
ولا زال جامع الشيخ الطوسي (قدّس سِرُّه) عامراً بالطلاب يستمعون فيه إلى محاظرات اساتذتهم ومدرسيهم (ينظر الملحق السابع عشر).
ومن الجوامع التي يعمرها طلاب الحوزة العلمية للبحث والتحصيل العلمي كذلك جامع الجواهري حيث مرقد المرجع الديني الاعلى في زمانه سماحة الشيخ محمد حسن الجواهري (قدّس سِرُّه) (ينظر الملحق الثامن عشر).
ومن الجوامع المعروفة بكثرة ارتياد الطلاب لها كذلك جامع (الشيخ الأنصاري)، وكنت أشاهد فيه المرجع سماحة السيد الخميني (قدّس سِرُّه) يلقي فيه أبحاثه ومحاضراته وخطبه التغييرية كذلك، ولازال هذا الجامع غاصاً باساتذة الحوزة العلمية واساتذتها يرتادونه للدراسة والتدريس. وغير هذه المساجد والجوامع كثير.
ويعدُّ (المسجد الهندي) من أشهر جوامع الدرس والتدريس والمباحثة في النجف الأشرف اليوم وقبل اليوم ومن أكثرها ازدحاما بالحلقات البحثية والدراسة والتدريس والمراجعة والتمحيص (ينظر الملحق التاسع عشر)، وقد تشرفت بالدراسة والمباحثة بين جنباته وقتا ما من دراستي الحوزوية القليلة.
ويحدثنا المؤرخون أن الحاج خان محمد أحد صلحاء الهند في أوائل القرن الثالث عشر الهجري هو الذي شيد هذا الصرح العبادي والعلمي الكبير، واستمر بعده العلماء الأعلام والمحسنون الكرام على إدامة عمارته وتجديدها وكان للمرجع الأعلى في وقته الإمام السيد محسن الحكيم المتوفى في (1390 ه/ 1970م) ثواب إصلاح عمارته وتجديد بنائها وإدامته، كما شيد مكتبته العامة العامرة ( مكتبة الإمام الحكيم العامة) خلف الجامع الكبير بحيث تنفتح بعض أبوابها عليه مثلما تنفتح عليه مقبرته (قدّس سِرُّه) ومقبرة أبنائه المظلومين من جهة، ومقبرة أخرى كبيرة خصصها لأساتذة وطلبة أسرته
ص: 275
العلمية (آل الحكيم)، حتى أن الداخل للدرس لا يدخل اليها إلّا من ساحة مسجد الهندي الواسعة كما لو كانت من بعض أواوينه، ولا زلت أذكر أن سيدي الوالد (قدّس سِرُّه) كان يلقي فيها دروسه في أصول الفقه على مستوى (البحث الخارج) بعد صلاة المغرب من كل يوم دراسي وحين وافاه الأجل ثوى فيها، وهكذا استمرت مقبرة الأسرة باحتضان الدروس العلمية حتى يوم الناس هذا (ينظر الملحق العشرون)
ومن أماكن الدراسة الحوزوية كذلك إضافة لغرف الصحن الحيدري وأواوينه وجوامعه المدارس الدينية وهي كثيرة في القرن الماضي، خلافا لما كان عليه الحال في القرن التاسع عشر كما سيأتي، وقد بنيت مدارس حوزوية تتبع أنظمة خاصة بها من أمثال مدرسة (دار الحكمة) التي أسسها المرجع الأعلى في عصره سماحة السيد الحكيم (قدّس سِرُّه) و دار العلم التي أسسها المرجع الأعلى في عصره سماحة السيد الخوئي (قدّس سِرُّه)، وقد فجّر المدرستين النظام البائد بعد الانتفاضة الشعبانية عام (1411 ه/ 1991م) الأولى بالديناميت بعد أن صادر مكتبتها العامرة وهدّ الثانية وصادر كتبها كذلك، وهناك غيرهما الكثير من المدارس العامرة اليوم بطلاب العلم كما سيأتي.
ومن أماكن الدراسة الحوزوية كذلك (الحسينيات) وهي كثيرة ومنها (الحسينية الشوشترية) التي هدمت زمن النظام البائد أيضا، وكنت أشاهد فيها المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدّس سِرُّه) يلقي فيها أبحاثه ودروسه.
ومنها حاليا حسينيات كثيرة أخرى منتشرة في مدينة النجف الأشرف القديمة خاصة ك(الحسينية الأعسمية) (ينظر الملحق الحادي والعشرون) و(حسينية آل محي الدين) (ينظر الملحق الثاني والعشرون) وغيرهما كثير ويرتاد الطلبة والأساتذة الحسينيات لإلقاء بحوثهم ومحاضراتهم.
ص: 276
وربما يتخذ الأستاذ وطالبه من بيت الأستاذ أو بيت آخر أو مكتب ما من المكاتب العلمية مكانا لدرسهما أو مناقشتهما العلمية (ينظر الملحق الثالث والعشرون).
وقد فتحت عينيّ على عمي المرحوم المجتهد المعذب سماحة السيد محمد حسين الحكيم (قدّس سِرُّه)، وعلى سيدي الوالد (قدّس سِرُّه)، ثم على ابن عمي الشهيد السيد محمد رضا السيد محمد حسين الحكيم، وهم يلقون دروسهم في مكتبة بيتنا الملحقة بقاعة المجلس الكبير (البراني) أو يلقونها أحيانا داخل قاعة المجلس الكبير نفسه الواقع في محلة الحويش إحدى المحلات الأربع المكونة لمدينة النجف الأشرف القديمة، وهكذا غيرهم ممن كنت أشاهدهم من أساتذة الحوزة العلمية ومدرسيها الكثر.
ص: 277
ص: 278
أشار بعض الباحثين(1) إلى بلوغ مدارس طلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف إلى (53) مدرسة حوزوية بنيت لتكون مكانا لدراسة الطلاب وسكنا مجانيا لغير المتزوجين منهم في آن واحد، حيث تتوفر في هذه المدارس أغلب المستلزمات الضرورية لسكن متواضع مكون من غرفة صغيرة تتسع لأثاث الطالب وأمتعته وكتبه الدراسية وأوراقه وملازمه وما إلى ذلك من شؤون حياته المختلفة، وبخاصة إذا كان من خارج مدينة النجف الأشرف، تخفيفا من عبء الدراسة ونفقاتها التي ربما تكون قاسية على الطالب من دون سكن مبذول له.
فمنذ ألف سنة والنجف مزدحمة بالطلاب يأتون اليها من مختلف الأصقاع عربية كلبنان والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسوريا وعمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها ودول غير عربية كالهند،والتبت والأفغان، وبلوجستان، وتركتسان،وقفقاسية وإيران وأفريقيا الشرقية حتى بلغ عدد الطلبة المهاجرين للدراسة إلى النجف الأشرف في فترات الازدهار حوالي خمسة آلاف طالب(2).
إن لكل مدرسة من مدارس النجف الدينية القديمة منها والحديثة أنظمة خاصة تعينها صيغة الوقف، لأن جميع هذه المدارس قد شيدت من الموقوفات التي وقفها العلماء، أو المحسنون على طلاب الدين، ولكل مدرسة شروط خاصة يقبل بموجبها
ص: 279
اسكان الطلاب في غرفها
وأغلب سكان هذه المدارس من الغرباء الذين يؤمون النجف بقصد الدراسة
ووصول مرتبة الاجتهاد وقد يقضون فيها عشرات السنين حتى يبلغوا المرام ويعودوا إلى بلدانهم مزودين بالاجازات التي يمنحها لهم اساتذتهم من المراجع الروحانية الكبرى.
ومنذ ألف سنة والنجف مزدحمة بالطلاب الذين يأتون اليها من مختلف الأصقاع،،كالهند،والتبت،والأفغان،وبلوجستان،وتركتسان،وقفقاسية، وايران وافريقيا الشرقية، ولبنان وسوريا ودول الخليج وغيرها، فضلا عن المدن العراقية.
وحين يقبل الطالب في المدرسة يعطى غرفة فيها وتكون هذه الغرف في بعض المدارس مفروشة ومجهزة بالكهرباء وذات منح نقدية تمنح للطالب في كل شهر أو في كل موسم، وموائد تقام على حساب المدرسة في أوقات معينة ولبعض الطلاب في مختلف المدارس مخصصات يومية من الخبز يتناولها من الخباز، وراتب شهري تدفعه له المراجع الدينية كل حسب مؤهلاته، وحسب إمكان المرجع الديني الذي يساعده، ومعظم طلاب هذه المدارس هم من الذين لم يتزوجوا بعد، ولم تخل هذه المدارس من طلاب نجفيين إلى جانب الطلاب الغرباء ممن لا طاقة له على توفير مثل هذا الجو في بيته سواء كان متزوجاً أو غير متزوج، لأن معظم المدارس لا تفرق بين الطالب الغريب وغير الغريب، ولكل طالب مفتاح يفتح به باب المدرسة متى جاء، وحين يغلق باب الحرم في المشهد المقدس ليلا يكون الطلاب غالباً قد أموا مدارسهم، وترى معظم الغرف في هذه المدارس مضاءة إلى وقت متأخر من الليل.
والطالب الغريب هو الذي يعد بنفسه طعامه في غرفته، وغالباً ما يكون هذا الطعام مؤلفاً من الخبز والتمر واللبن، وقد روى الراوون روايات كثيرة عن عدد من كبار
ص: 280
العلماء النابغين الذين عاشوا في مثل هذه المدارس على الخبز وحده، وكثير منهم من كان يطوي اليوم واليومين دون أن يحصل على قوت يومه ملتذاً بالصبر، والفناء فيما هو فيه من التتبع. وهكذا كانت بالاجمال حياة هذه الطبقة من طلاب العلم، وسكان المدارس ولم تزل تجري على هذه الوتيرة مع شيء من الفروق القليلة.(1)
ويصف لنا الدكتور فاضل الجمالي تصميم وهندسة هذه المدارس فيقول: إن كل مدرسة من هذه المدارس تتكون على الأغلب من باحة مفتوحة على شكل مربع أو مستطيل، وفي وسطها بركة ماء محاطة بالأشجار كما تحاط هذه الباحة المربعة بغرف يسكنها طالب أو طالبان ويكون فيها الدور الأرضي مرتفعا بما يقرب المتر عن الأرض، وقد زرت بعض غرف الطلاب ولم تكن فيها أسرّة، وكان الطلاب ينامون على فرش يمدونها فوق السجاجيد والحصران.
أما تهويتها فتتم إما عن طريق الشبابيك أو عن طريق المداخن و(يقصد بها ما يصطلح عليه في عرف النجفيين بالبادكير، وهو منفذ هوائي يوصل بين الغرفة أو السرداب وسطح المدرسة) وبعضها الآخر لم يكن فيها تهوية إلّا من الباب.
وتحتوي بعض هذه الغرف على تدفئة متنقلة، كما أن معظم المدارس تحتوي على سراديب ومخازن تحت الأرض يلجأ اليها الطلبة أثناء الصيف القائظ، وبعض سراديب النجف تكون أكثر من دور واحد، وكلما نزل الشخص إلى عمق سرداب أو اثنين أو ثلاثة فإن البرودة تزداد بشكل تدريجي حتى أنه يحتاج إلى ملابس ثقيلة في السرداب الثالث إذا أراد أن يحتمي منها.
كما وصف لنا الشيخ الخليلي تصميم هذه السراديب فقال : لقد روعي في هندسة المدارس العلمية في النجف طبيعة البلد فكان لابد من حساب (للسراديب) في أغلب
ص: 281
أبنية المدارس وتقوم هذه السراديب في جهة واحدة من عمارة المدرسة أو جهتين أو الجهات الثلاث أو الجهات الأربع من العمارة ينزل اليها بواسطة سلالم، وتسمى بالسراديب الفوقانية في مصطلح النجفيين، وفي بعض المدارس الأُخرى سراديب تقام تحت السراديب الفوقانية وهي ما تسمى بالسراديب (نيم سن) والكلمة فارسية معناها منتصف (السن) والسن طبقة من الرمل المتحجر ينحت فيه الناحت سرداباً آخر، وهنالك من السراديب ما هو أعمق من (النيم سن) ويسمى بسرداب (السن) ويحفر (للسن) أو (للنيم سن) في وسط المدرسة حفيرة على هيئة متوازي الأضلاع بقطر مترين أو أقل من ذلك وفي عمق عشرين متراً أو أقل من ذلك لينفذ هذا الحفر من متوازي الأضلاع إلى وسط السرداب بقصد ايصال النور وسحب الماء البارد إلى الأعلى كما تحيط بالسراديب من أطراف أعاليها شبأبيك لنفوذ النور والهواء، فضلا عن عدد من المنافذ الهوائية المتصلة من أعلى سطح العمارة بالسراديب الفوقانية وهي التي تسمى (بالبخاريات) ثم تبنى هذه السراديب في الغالب بالآجر وتزخرف وقد تترك سراديب السن على حالها وهي منحوتة من طبقة السن التي تشبه الصخور أو تزين جدرانها بالآجر وقد تزين الجدران وأرض السراديب بالكاشاني.
وكثيراً ما تفتح في السراديب منافذ تتصل ببئر المدرسة إذ المفروض أن يكون في كل بيت وفي كل عمارة بئر ماء تتصل بالبئر المجاورة لها وهذه تتصل ببئر أسخرى. وهكذا حتى تتجمع المياه في بئر كبيرة تستمد مياهها من نهر الفرات ويتحول السكن في الصيف في وسط البيت أو وسط المدرسة إلى هذه السراديب وتتم فيها المطالعة وتناول طعام الغداء والقيلولة وقد تمسي في بعض ليالي الصيف عند اجتياح العواصف الرملية المدينة ملاذاً للطلاب يقضون فيها الليل نياماً(1).
ولقد أحصيت المدارس في (عام 1385 ه/ 1965م) فكانت اثنتين وثلاثين
ص: 282
مدرسة فيها اثنتان و خمسون وتسعمائة غرفة.
وربما تعد المدرسة (المرتضوية) التي يظن أن الرحالة ابن بطوطة قد زارها حينما زار النجف سنة (737ه / 1337 م) هي أقدم مدرسة من مدارس الحوزة العلمية في النجف الأشرف كما ورد ذكرها أيضا في نهاية مخطوطة لمحمد بن علي الجرجاني ختم كاتبها كتابتها سنة (720 ه / 1320م) وفرغ من نسخها في المدرسة المرتضوية في النجف الأشرف ناسخها حيدر بن علي بن حيدر سنة (762ه / 1361م)، ثم تأتي بعدها (المدرسة السليمية) أو مدرسة المقداد السيوري الفقيه الحلي صاحب كتاب كنز العرفان في فقه القرآن المتوفى عام (828ه / 1328م) حيث أنشئت في أوائل القرن التاسع الهجري، ولا تزال قائمة لليوم، وقد ورد ذكرها في ختام نسخة من كتاب مصباح المتهجد لشيخ الطائفة الطوسي قد فرغ منها في مدرسة المقداد السيوري ناسخها عبد الوهاب السيوري سنة (832 ه/ 1332م)، أعقبتها (مدرسة الشيخ عبد اللّه اليزدي) المتوفى عام (981 ه/ 1573م) حيث أنشئت في منتصف القرن العاشر الهجري في المحلة المعروفة بمحلة المشراق، تلتها (المدرسة الغروية) التي أنشأها السلطان عباس الصفوي المتوفى عام (1038ه/1629م) في أوائل القرن الحادي عشر الهجري في الزاوية الشرقية من الصحن العلوي الشريف، ثم (مدرسة الصدر) التي أنشأها الوزير محمد حسين الأصبهاني المتوفى عام (1239 ه/ 1824م) في نهاية السوق الكبير في سنة (1226 ه/ 1811م)، ثم (مدرسة المعتمد) التي أنشئت في محلة العمارة قرب قبور المشايخ من آل كاشف الغطاء قبل سنة (1262ه / 1846م)، (فالمدرسة المهدية) التي شيدت في محلة المشراق سنة (1284 ه / 1867م)، (فمدرسة القوام) التي بنيت في محلة المشراق سنة (1300 ه/ 1883م)، (فمدرسة الإيرواني) التي أسست في محلة العمارة سنة (1305 ه/ 1887م)، (فمدرسة الخليلي الكبرى) في محلة العمارة سنة (1316ه
ص: 283
1898م)، (فمدرسة البخاري) في محلة الحويش سنة (1319 ه/ 1901م)، (فمدرسة الآخوند الكبرى) في محلة الحويش كذلك في سنة (1321 ه/ 1903م)، (فمدرسة الخليلي الصغرى) في محلة العمارة سنة (1322 ه/ 1904م)، (فمدرسة القزويني) في محلة العمارة أيضا سنة (1324 ه/ 1906م)، (فمدرسة البادكوبي) في محلة المشراق سنة (1325 ه/ 1907م)، (فمدرسة الآخوند الوسطى) في محلة البراق سنة (1326 ه/1908م)، (فمدرسة اليزدي الكبرى) و(مدرسة الشربياني) في سنة (1327 ه/1909م)، (فمدرسة الهندي) و(مدرسة الآخوند الصغرى) في محلة البراق سنة (1328 ه/ 1910م)، (فمدرسة السيد عبد اللّه الشيرازي) في محلة الجديدة سنة (1372 ه/ 1953م)، (فمدرسة البروجردي الكبرى) في الجانب الشرقي من الصحن العلوي المطهر سنة (1373 ه/ 1954م)، (فالمدرسة الطاهرية) سنة (1377 ه/ 195م)، (فالمدرسة اللبنانية) في خان المخضر سنة (1377 ه/ 1958م)، (فمدرسة الرحباوي) في سنة (1378 ه / 1959م، (فمدرسة البروجوردي الصغرى) في سوق العمارة من محلة العمارة سنة (1378/ 1959م)، (فجامعة النجف الدينية) في حي السعد سنة (1382 ه/ 1963م)، و(مدرسة الجوهرجي) في شارع المدينة سنة (1382ه- 1963م) ايضا، (فمدرسة عبد العزيز البغدادي) في ساحة ثورة العشرين من جهة طريق كربلاء سنة (1383ه/ 1964م)، (فالمدرسة الشبرية) في محلة البراق سنة (1385ه/ 1966م)، و (دار الحكمة) في شارع زين العابدين سنة (1385 ه / 1966م)، (فمدرسة البهبهاني) في شارع زين العابدين سنة (1390 ه/ 1971م)، وكذلك (مدرسة الأفغانيين) في محلة الجديدة و(مدرسة السيد الخوئي) في دورة الصحن من جهة العمارة في سنة (1395 ه/ 1976م)، وقد هدمت قبل أن يكمل بناؤها، و(مدرسة الكلباسي) في سنة (1395 ه/ 1976م)، و(مدرسة البغدادي) في
ص: 284
شارع أبي صخير، وهي غير مدرسة البغدادي المتقدمة، و(مدرسة الإمام الحكيم) في شارع أبي صخير أيضا، و (المدرسة الأزرية) في خان المخضر، و(مدرسة أمير المؤمنين)، و (مدرسة الحسن بن علي)، (والمدرسة الأحمدية).
ولعل من أجمل المدارس القديمة (مدرسة الخليلي الكبرى) التي أسسها الميرزا حسين الخليلي في محلة العمارة في النجف عام (1316 ه/ 1898م)، وتشتمل على ست وأربعين غرفة من طابقين مقامة على مساحة تقدر بستمائة متر مربع متخذة شكل بناء مربع، وقد كسيت جميع جدرانها بالقاشاني المنقوش بريشة فنان مبدع، محولا إياها إلى لوحة هندسية فنية رائعة، حيث هدمها نظام صدام البائد مع ما هدم من المدارس والجوامع والحسينيات والمكتبات ودور العبادة ومنازل العلماء الكبار ومقابرهم ومنازل المجتهدين والمجاورين الواقعة ما بين الصحن الشريف ومرقد العبد الصالح (صافي الصفا) مقررا بدلها في محاولة لطمس آثار المدينة التاريخية ومنازل العلماء الأعلام ومحال تدريسهم ومكتباتهم ومدارسهم فنادق سياحية ومرآب للسيارات ولكن عمر النظام الصدامي قصر عن إتمام مشروعه التخريبي فكان أن هدمت المحلة بآثارها التاريخية ودياراتها ومكتباتها ولم تنجز الفنادق والمرآب.
أما المدارس الدينية الحديثة فلعل أجملها بناء وعمارة (جامعة النجف الدينية) و(دار الحكمة) التي شيدها المرجع الأعلى في زمانه الإمام السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) بطوابق ثلاثة ضمت بحدود مائة وخمسين غرفة عدا القاعات في هندسة فريدة تربعت فوق قطعة أرض مساحتها 714 مترا مربعا عام (1385 ه/ 1965م)، ثم اقتحمتها وفجرتها قوات النظام البائد بعد قصفها النجف الأشرف بالمدافع الثقيلة والصواريخ ثم اقتحمتها بالآليات الثقيلة والدبابات والمجنزرات ما أدى إلى القضاء على الانتفاضة الشعبانية الجماهيرية عام (1411ه/ 1991م) ثم تفجير هذا الصرح العلمي والمعماري الرائع.
ص: 285
أما وقد وصل بي الحديث إلى هذا الموضع فإنه ليحسن بي أن أضيف بأن أكثر المدارس الدينية المشغولة في العام (2011م / 1432ه) هي المدارس التالية:
مدرسة اليزدي، ومدرسة الآخوند الكبرى، ومدرسة الآخوند الوسطى، ومدرسة القوام، ومدرسة القزويني، والمدرسة الهندية ومدرسة الصدر الأعظم، ومدرسة أمير المؤمنين، ومدرسة البروجوردي، ومدرسة الحسن بن علي، والمدرسة اللبنانية، والمدرسة الأحمدية، وهناك غيرها لا يسع المجال لذكرها.
ص: 286
كثيرا ما يبتدئ طالب الحوزة العلمية المشتغل المجد في التحصيل يومه الدراسي كما كنت أرى وألحظ وأشاهد من بعد طلوع الشمس وربما قبل ذلك، ويواصل ذلك حتى الزوال دارسا أو مدرسا، فإذا ما صلى الظهر والعصر وطعم واستراح، عاد ثانية بعد العصر للدرس والمذاكرة، فإذا غربت الشمس تفرغ للصلاة والذكر، فإذا انتهى من صلاته وتعقيبه تهيأ للقيام بما تفرضه عليه الأعراف والعلاقات الاجتماعية والمستحبات الشرعية من مواصلة للمؤمنين ومشاركتهم في أفراحهم وأحزاناتهم، ومن حقوق تفرضها الأبوة والبنوة والأخوة والرحم، وواجبات تستدعيها الصحبة والصداقة والجيرة، وأمثالها، فإذا أتم الطالب ما ابتدر اليه من واجبات اجتماعية وأسرية عاد ثانية لكتابه ودرسه و و أستاذه، أو لتلميذه وإشكاله وإشكالات طلاب الحوزة العلمية كثيرة حتى إذا فرغ من ذلك كله وأخذ قسطا من الراحة وتناول ما جاد به ربه عليه من مأكل ومشرب، نشط لكتابة درسه الفائت والتحضير لقابل يومه الآتي، وهكذا دواليك. وليس غريبا أن تسمع من بعضهم قوله بأننا كنا ندرس في اليوم (14) درسا، فلم يكن لنا شغل من أول الصبح إلى الليل سوى الدراسة والمطالعة والبحث(1).
يقول الباحث الدكتور فاضل الجمالي بعد زيارته الميدانية البحثية للنجف سنة 1957/ 1376ه : سألت أحد الطلبة وهو الشيخ محمد رضا شمس الدين أن يوضح لي منهاجه اليومي فذكر لي أنه ينهض صباحا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة ليؤدي
ص: 287
صلاة الفجر، وبعد شروق الشمس يحضر (بحث الخارج) على يد السيد أبي القاسم الخوئي في الفقه وبعدها يتجه إلى تدريس البلاغة والفلسفة الإسلامية في كتاب يسمى (شرح الباب الحادي عشر) للمقداد السيوري، عندها يحضر درسا فقهيا آخر في (بحث الخارج) للشيخ عباس الرميثي يعالج جانبا من شرح كتاب شهير هو كتاب (الشرائع)، ثم تأتي المحاضرة الثالثة (لبحث الخارج) في مباحث الزكاة من الفقه من نفس المصدر. ثم يستمر بالحضور على يد السيد علي الفاني الأصفهاني في محاضرات (البحث الخارج) الأخرى.
وهو مع كل ذلك كان عليه أن يستعد للدراسة والتحضير بنفسه وألّا يتخلف عن مواعيد الصلوات وما يحتاجه لشؤون حياته الخاصة وبالتأكيد فإن هذا البرنامج هو برنامج مليء بالحيوية. وبعبارة أخرى فإن الطالب يمكن أن يتعب نفسه إذا رغب أو يتركها وشأنها إذا كان ذلك رائقا له. وبالنتيجة لا توجد أي قوة خارجية تجبر الطالب على أداء مهماته سوى ما تمليه رغبته عليه(1).
لقد سألت أحد الطلبة الحاليين المشتغلين في حوزة النجف الأشرف وهو الشيخ علي جاسم البهادلي عن يوم عمله الدراسي فكتب لي في الثالث عشر من ربيع الأول سنة 1428ه / 2007م ما يأتي: استجابة لما ندبني إليه بعض الإخوان من تدوين ما وفقني اللّه إليه مما دأبت على فعله في ما يتعلق بطلب العلم في حوزتنا المباركة وكيفية توزيع الوقت في اليوم والليلة إلى تمام الأسبوع بما يمثل النهي الذي اعتده من تحصيل المطالب العلمية وأداء التكاليف الشرعية فأقول معتذرا إن يكن غير واف بالنصاب :
دأبت بفضل اللّه تعالى على الاستيقاظ قبل صلاة الصبح بما يسع صلاة الليل التي ورد الحث عليها من الشرع الشريف بما لا يسع المجال لاستقصائه وأداء نافلة الفجر ثم الاشتغال ببعض الأذكار التي وردت بين صلاة الصبح ونافلتها حتى أذا حان وقت
ص: 288
فضيلة الواجبة صليتها جماعة بأهلي ثم عقبت قليلاً مستذكرا مصيبة سيد الشهداء فينهل له دمعي وينكسر لمصابه قلبي وهو أدنى ما ينبغي له (عَلَيهِ السَّلَامُ) ممن صدق في حبه حتى أذا ما لملمت نفسي غدوت بها إلى مذاكرة البحث في الفقه والأصول تقريراً ومطالعة ثم اتجهت بعد ذلك لحضور بحث أستاذنا سماحة السيد محمد رضا السيستاني دامت إفاضاته في خارج الفقه في تمام الساعة السابعة صباحا لأتجه بعد ذلك لحضور بحث أستاذنا لسماحة السيد محمد باقر السيستاني دامت إفاضاته في خارج الأصول في الثامنة إلا ربعا لأغدو بعد ذلك إلى المباحثة مع بعض الأخوة في بحث الفقه عند الثامنة والثلث تقريباً، ثم لأحضر بعد ذلك في تمام التاسعة خيارات المكاسب عند سماحة الشيخ محمد هادي آل راضي دامت إفاضاته، حتى إذا بلغت الساعة العاشرة اتجهت إلى بعض إخوتي من طلبة العلم لألقي عليهم ما شرعت فيه من درس شرائع الإسلام وعند حلول الحادية عشرة يكون موعدي مع بعض إخوتي من طلبة العلم للمباحثة في بحث الأصول.
حتى إذا ما قارب اللقاء المرتقب مع الحبيب الأوحد أسرع قلبي إليه قبل بدني ليغترف من فيض حنانه وينهل من معين إحسانه على حالة لا أرى سواه ولا أرى أنه يرى سواي فأبته ما أبله فلا أكاد انقطع عنه حتى يقطعني التسليم لأعقب بعده ذاكرا وأسجد له شاكرا لما وفقنى لأداء فرائضه ونوافله حتى إذا انفض الجمع خرجت مودعا مولى المتقين ويعسوب الدين مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) منحنيا له بالتبجيل والسلام.
ثم أصل إلى المنزل فاجتمع بالأهل على الغداء فألبث بعض الوقت بينهم ثم لا أملك إلّا أن اجيب بدني إلى قسط من النوم ليوقظني بعد ذلك بعض من معي لأتهيأ إلى صلاة المغرب فأوديها جماعة بالأهل حتى أذا سلمت عقبت قليلا مستذكرا ما أستذكره بعد كل صلاة غالبا من مصيبة سيد الشهداء (عَلَيهِ السَّلَامُ) لينهل دمعي له وهو أقل ما علي له
ص: 289
ثم أصلي النوافل لأدي بعدها صلاة العشاء ونافلتها معقبا بعدها ومستذكرا، ثم بعد الانتهاء أتابع الاخبار في التلفاز ثم أجلس مع الأهل لوجبة العشاء أقوم بعدها الساعة التاسعة لمذاكرة الدروس مستمرا إلى الساعة الثانية عشرة والنصف على تفاوت يسير في بعض الأحيان لأخلد بعدها إلى النوم فأستيقظ على ما دأبت عليه بفضل اللّه تعالى قبل صلاة الصبح بما يسع صلاة الليل ونافلة الفجر والفريضة لاستقبل يوما جديدا بما ودعت به أخاه إلا ليلة الخميس من كل أسبوع فقد أتفرغ عن المذاكرة فيها.
وأما يومي الخميس والجمعة فأحضر درسا في علم الرجال لدى فضيلة السيد محمد صادق الخرسان دامت توفيقاته وأذاكر مع بعض الأخوة بعض من مباحث علم الأصول.
ثم إني أغتنم أوقات التعطيل في أيام الخميس والجمعة والمناسبات الدينية بإكمال ما شرعت فيه من تأليفات حيث أتممت حاشية على بعض كتب المنطق وحاشية على بعض كتب الكلام وآخرها أتممت كتابا عن الحج يقع فوفقني الباري تعالى لإتمامه وصار في متناول الطباعة.
وبعد فهذه سيرة يوم عملي الدراسي ذكرتها وأخالها لا تمثل إلّا أقل النصاب مما كان عليه دأب علمائنا الأعلام الذين أفنوا أيام حياتهم في الجد والاجتهاد حتى بلغوا بفضل اللّه تعالى ما بلغوا مما ليس بأيدينا منه إلّا مقدار ما ينهل الطير من البحر فنشكو إلى اللّه فتور العزم وضعف الهمة ونسأله أن يأخذ بأيدينا إلى المراتب السنية والدرجات العلية وإن قلت البضاعة وكثرت الإضاعة إنه رحيم ودود.
كما أجابني الشيخ هيثم الرماحي الطالب المشتغل في حوزة النجف الأشرف أيضا عن برنامج يوم عمله الدراسي قائلا : " يبدأ يومي الدراسي بالنهوض بعد صلاة الفجر
ص: 290
ثم قراءة دعاء الصباح ودعاء العهد ودعاء اليوم للإمام زين العابدين (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعد صلاة الفجر، وأحياناً أراجع بعض الدروس قبل تناول طعام الافطار ومن ثم الخروج إلى الدرس بصحبة مجموعة من أخوتي الطلبة، نجتمع لأستئجار سيارة صغيرة تقلنا إلى مقربة من مكان الدروس.
الدرس الأول (خارج أصول) للأستاذ السيد محمد باقر السيستاني (دام عزه) وذلك في الساعة 6:45 صباحاً. وبعد درس الأصول يبدأ درس المكاسب مباشرة لأجد بعد ذلك القليل من الوقت أجدد في الوضوء وأقوم بزيارة أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ).
بعد ذلك وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً أبدأ بتدريس الأصول الحلقة الثانية للسيد محمد باقر الصدر (قدّس سِرُّه) ثم أشرع بعد ذلك بتدريس كتاب الشرائع، ثم أتوجه إلى مدرسة السيد اليزدي (قدّس سِرُّه) للتباحث مع اثنين من الأخوة الطلبة بما قررناه من درس البحث الأصولي. لأتوجه بعدها لأداء الصلاة في المسجد الهندي أو أحياناً في مدرسة السيد البروجوردي (قدّس سِرُّه).
أبقى في المدرسة في فترة الظهيرة مع أخٍ لي للتباحث وتقرير بحث الأصول والتحضير لما أجده في المدرسة من أجواء هادئة والابتعاد هذه المدة عن الجو التقليدي والبرنامج الروتيني في البيت وأحيانا أشتري من السوق الطعام القليل للغداء وأحياناً أخرى اتناول طعام الغداء في المدرسة والذي يقدم لطلبة الساكنين فيها.
ثم أتوجه عصراً للدار الواقع في أحد الأحياء الشمالية لمدينة النجف للتحضير للدروس الأخرى والتهيؤ لصلاة المغرب في المسجد القريب من دارنا بعد ذلك أقوم بقراءة نصف جزء من القرآن الكريم بعد صلاة العشاء وأقرأ أحياناً زيارة عاشوراء.
كما استمع أحيانا لبعض المحاضرات الأخلاقية وغيرها عن طريق الانترنت
ص: 291
للعديد من الفضلاء والعلماء ثم أقوم بطباعة ما كتبته من تقريرات بواسطة الحاسوب وأعطي لزملائي التقريرات التي كتبتها أحياناً إن شغلهم شاغل عن ذلك ونفس الأمر ينطبق علي أيضا فأحيانا أستعين ببعض الأخوة الذين قرروا الدرس على الحاسوب وأعوض ما فاتني منها.
ثم اني أحاول قراءة شيء من الكتب غير المنهجية يومياً وأختم يومي بقضاء صلاة يوم واحد لأعوض ما فاتني أيام الصغر.
وقد اعتدت في يوم الأربعاء أن أسافر للتبليغ إلى مدينة الشنافية التي تبعد مسافة 70 كم جنوب النجف والتي هي مسقط رأسي علماً أنني معتمد المرجعية في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة.
فأصل عصراً لحسينية الثقلين في الشنافية وتكون صلاة العشائين فيها وبعد ساعة ونصف من إكمال الصلاة يجتمع المؤمنون مرة أخرى في الحسينية المذكورة لألقي أنا وأحد الأخوة المشائخ أو السادة الذين اصطحبهم معي لمدينتي لإقامة مجلس حسيني تطرح فيه غالبا العديد من المطالب الأخلاقية والعقائدية والفقهية حيث يجيب الضيف المحاضر عن أسئلة الشباب الذين يحفّون به خصوصاً إنني أحضر أحيانا معي بعض الأخوة من مكتب الاستفتاءات التابع لمكتب آية اللّه العظمى السيد علي السيستاني (دام ظلّه) ليجيب عن تساؤلاتهم المتعددة.
كما اعتدت أن أقيم الصلاة ظهر يوم الخميس في مسجد الإمام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الصوب الآخر من مدينة الشنافية لأن هذا المسجد تؤمه مجموعة طيبة أخرى من المؤمنين سبق أن قمت بتدريسهم قبل سنوات الفقه والعقائد والأخلاق ودأبت على تعاهدهم وإلقاء محاضرة عليهم بين الفرضين من الصلاة الواجبة.
ص: 292
بعد ذلك أقيم صلاة العشائين في مسجد الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وفيه ثلة طيبة مثقفة من المؤمنين علماً بأن بداية إمامتي لصلاة الجماعة كانت في هذا المسجد حتى إذا انتهت الصلاة توجهت صوب كربلاء لزيارة الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وأحيانا ألقي على جموع المصلين محاضرة قصيرة بين الفرضين. هناك.
أعود في التاسعة إلى حسينية الثقلين في الشنافية لقراءة دعاء كميل وشرح فقرة من فقراته ثم أقوم بشرح بعض المطالب الفقهية من الرسالة العملية وفي هذه الأيام يأتي العديد من المؤمنين لأقوم بقضاء حاجاتهم عن طريق المساعدة المالية أو إجراء المصالحة في شأن الخمس أو حل بعض المشاكل المتعلقة بالإرث والوصية وبعض المشاكل العائلية كما أقوم بتوزيع ما جلبته من كتب وإصدارات جديدة وأحيانا أطبع لهم ما أراه مفيداً من الأنترنت لأوزعه عليهم.
هذا بالإضافة إلى مكثي في الشنافية للخطابة والصلاة في شهر رمضان المبارك وأيام محرم الحرام الأمر الذي جعل الكثير من الشباب وبقية الشرائح منشدة مشتاقة لقدوم يوم الأربعاء للتعرف على شيخ أو خطيب آخر وسماع محاضرة جديدة والتعاهد فيما بيننا بالحق وبالصبر حتى أننا التزمنا بأن يوقظوني وأوقظهم لصلاة الليل وأنا في النجف وهم في الشنافية عن طريق التنبيه القصير بالهاتف النقال.
كل ذلك في يوم الخميس أما إذا حلّ يوم الجمعة فإني أعود صباحا إلى النجف الأشرف لحضور درس الرجال في بيت أستاذي السيد محمد صادق الخرسان ثم ليبدأ يوم مبارك جيد مع ما يرافقه من مستحبات والتزامات.
أسأل اللّه أن يوفقنا وجميع المؤمنين لما فيه الخير والصلاح.
ص: 293
ص: 294
(1) سورة التوبة: آية 122
(2) مجلة المنار. الجزء الأول من المجلد الحادي عشر. صفر. سنة 1326 ه. ص : 45.
(3) المدارس القديمة والحديثة في النجف. الشيخ محمد الخليلي: 77.
(4) النجف الأشرف مهد الفضيلة والعلم. سابق : 70.
(5) الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 4 / 367.
(6) ينظر : كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني. تحقيق سامي الخفاجي :20/1.
(7) ينظر : فصول من تاريخ النجف وبحوث أخرى. عبد الرحيم محمد علي : 1/ 355.
(8) ينظر: المصدر السابق، والشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. سابق : 20.
(9) جامعة النجف الدينية د. فاضل الجمالي. نقله إلى العربية د. جودت القزويني. مجلة شؤون إسلامية. العدد 2 السنة الثانية 1420ه-. ص : 12.
(10) المصدر السابق نفسه.
(11) موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية. سابق : 1/ 378.
(12) مؤسسة الدراسة الدينية الشيعية في النجف وكربلاء خلال القرن التاسع عشر من منظور غربي، مائير لدفك أنموذجا. محمد عبد الهادي الحكيم (مخطوط): 15-16.
ص: 295
(13) ينظر : موسوعة النجف الأشرف جامعة النجف الدينية: 6/ 191
(14) ينظر المصدر السابق : 144
(15) مدارس النجف القديمة والحديثة. سابق : 4 وما بعدها.
(16) المصدر السابق: 10 وما بعدها.
(17) النجف الأشرف مهد العلم والفضيلة. سابق : 71.
(18) جامعة النجف الدينية. سابق: 17-18.
ص: 296
ويتناول هذا الفصل مبحثين هما :
المبحث الأول : بعض من إيجابيات النظام التدريسي المتبع في حوزة النجف الأشرف
المبحث الثاني: بعض من سلبيات النظام التدريسي المتبع في حوزة النجف الأشرف
ص: 297
ص: 298
للنظام التدريسي المتبع في الحوزة العلمية النجفية إيجابيات كثيرة أدرج منها ما يأتي:
أولا: لعل في مقدمة إيجابيات منظومة العقل الشيعي المستقى من سنة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) و من منهج الحوزات العلمية في التفكير والممارسة، هو فتح باب الاجتهاد، الملازم لأبدية الشريعة الإسلامية. ذلك أن هذه الأبدية للشريعة الإسلامية وانسجامها مع الحياة العامة في كل عصر تستدعي ضرورة حركة فكرية اجتهادية ذات طابع إسلامي على طول الخط لكي تفتح الآفاق الذهنية وتحمل مشعل الكتاب والسنة في كل عصر ودور، ولولا هذه الحركة الفكرية الاجتهادية في الإسلام في غياب دور المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ) وتطورها وتعمقها عصرا بعد عصر بتطور الحياة واتساعها وتعمقها بمختلف جوانبها الاجتماعية والفردية والمادية والمعنوية ما تبلورت إصالة المسلمين في التفكير والتشريع المتميز الملائم مع الحياة في كل عصر والمستمد من الكتاب والسنة على طول التاريخ في عصر الغيبة فلو لم تكن هذه الحركة الفكرية الاجتهادية مستمرة طول التاريخ وفي كل عصر لأنطفأ مشعل الكتاب والسنة في نهاية المطاف وظلت المشاكل الحياتية في المجتمع الإسلامي من الجانب الاجتماعي والفردي في كل عصر بدون حل صارم، ولهذا يتطور علم الفقه ويتسع ويتعمق تدريجيا تبعا لتطور الحياة العامة واتساعها دقة وعمقا في جميع المجالات الحياتية على طول الخط ويؤكد في المسلمين أصالتهم
ص: 299
الفكرية المتميزة في تمام جوانب الحياة وشخصيتهم التشريعية المستقلة.
وعلى هذا الأساس فلا بد في كل عصر من قيام جماعة لبذل أقصى للوصول إلى مرتبة الاجتهاد الكاملة وتحمل مصاعبها ومشاقها(1).
وقد تجلى ذلك في الحوزة العلمية في جامعة النجف الأشرف بصورة خاصة، فقد فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه فيما تبحث وتناقش وتعلّم وتتعلم، وتميزت بشدة تبحرها في هذا المجال، فقد تركت المجال للعقول تتصارع في سبيل البلوغ إلى الحق من طريق الجدل العلمي لتأخذ من ثمرات ذلك الصراع تجارب تنبض بالحركة والحياة.
والصراع العقلي متى كانت بواعثه بلوغ الحقيقة كان من أهم أدوات التطور والنمو في أي ميدان دخل فيه من ميادين العلوم أو الآداب، وهذا التطور الذي دخل على الفقه و أصوله في هذه الجامعة سواء في المناهج أم الأساليب كان من أقوى الثمرات لذلك، ولو قدر لنا أن نتابع دراسة الفقه في مختلف عصوره لانتهينا فيما أخال إلى سلسلة من التجارب متلاحقة في بساطتها وعمقها تسلمك كل واحدة منها إلى لاحقتها لتدرسها دراسة فاحصة وتضيف عليها ما جدّ لديها من آراء و تجارب(2).
ولو أردت أن استشهد بمثل على تغيير المباني في مدرسة النجف العلمية نتيجة تفاعل وتلاقح الآراء جرّاء فتح باب الاجتهاد لقلت إن المدرسة النجفية كانت قبلا تتبنى فكرة أصالة الماهية، وبعد ذلك تبنت فكرة أصالة الوجود، وكانت لا تميز بين الإمارات والأصول فاصبحت تفرق بينها بعد ذلك، وكانت نظرية انسداد باب العلم تجد مجالها في البحث كمسألة ذات وقع، ثم انحسرت بعد ذلك حيث أصبح الباحثون جميعا يؤمنون بانفتاح باب العلم، وكذلك تعرض المسألة الواحدة لعدة نتائج مختلفة في فترة زمنية قصيرة.
ص: 300
وما أيسر أن يجد الباحث في أصول الفقه رأيا للشيخ الأنصاري، وتعقيبا عليه للمحقق العراقي أو النائيني، وملاحظة عن التعليق لباحث من المعاصرين، ورأيا في الملاحظة لآخر منهم.
وهذا الاحتكاك الذهني الذي يشبه التضارب الفكري بين الباحثين يؤدي إلى تعميق المباحث الفقهية والأصولية وتطوير المفاهيم العلمية وتجديد النظر في صياغة إطار البحث.(1)
ثانياً : إن الدافع إلى التعلم في الحوزة وصولا إلى الاجتهاد هو نيل رضا اللّه عز وجل والخروج من عهدة التكليف الإلهي فلا المال ولا الشهرة ولا الدرجة العلمية ولا المركز الاجتماعي ولا المنصب ولا الجاه ولا غير ذلك من أمور الدنيا الفانية هو هدف المعلم والمتعلم الصادق مع نفسه في الحوزة العلمية الدينية، وهو ما بدا واضحا في حياة وسيرة العديد من أساتذة وطلاب الحوزة العلمية حيث عانى كبار الأساتذة والمراجع فيها ما عانوا من آلام ومحن وصعوبة عيش وجشب، ومع ذلك كله فقد تحملوا المعاناة الشديدة برضا حتى لهانت عليهم شدتها المحببة لديهم لهوان الدنيا نفسها عليهم، ولا يتصور القاريء أن حالة الزهد والورع والفقر المحببة إلى نفوس هؤلاء حالة فردية تخص حياة هذا المرجع أو ذاك، إنما هي أو ذاك، إنما هي ديدن أولئك المتقين ودأب هؤلاء المتعلمين وشواهدي على ذلك كثيرة لا يسع المجال لاستقصائها وإن أحببت ذكر نتف منها موعظة وذكرى لأولي الألباب، لذا فسأقتصر على ذكر القليل منها مما لم يكثر تداوله فيشتهر بين الخاصة والعامة من أمثال ما اشتهر من سيرة زهد المرجع الأعلى في عصره سماحة الشيخ مرتضى الأنصاري وتواضعه فهي معروفة(2)، حيث سأسعى لتخطي ذكر سير المراجع الذين مضى على زمان وفاتهم وقت ليس بالقصير من أمثال فقر وزهد المرجع المجاهد الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني الذي نقل عنه قوله : إن أدام طعامي مدة ثلاثين يوما
ص: 301
هو عبارة عن حرارة الخبز الذي أتناوله(1). كما سأتجنب ذكر حالة فقر وتقشف العلماء والمراجع الذين لم يعد لهم مقلدون أحياء في زماننا هذا من أمثال ما حكي في حياة السيد أبي الحسن الأصفهاني (المرجع الأعلى في عصره) زمن دراسته من أنه في مرة من المرات لم يكن لديه إيجار البيت فألقى صاحب الدار به وعياله وأثاثه خارجا فبات مع عائلته في غرفة من غرف مسجد الكوفة حيث لم يكن يملك بيتا فحسب، بل ولا يملك إيجار البيت وحدثني بعض الأصدقاء بأنه كان يتحدث مع بعض الطلاب وإذا به يغشى عليه في أثناء الكلام فلما أفاق قال إنه لم يأكل من ثلاثة أيام(2) و أن إمام الثورة الميزا محمد تقي الشيرازي حينما عرف حاجته وعوزه بعث له بمبلغ خمسمائة ليرة ذهبية ليشتري بها دارا له وذلك في أيام حاجته وضنكه فلم يمد يده إلى المبلغ، بل أودعه لدى بعض الخبازين وبدأ يحوّله خبزا للطلاب والفقراء المعوزين(3).
أقول سأتجاوز ذلك كله ما كان وقع منه في الماضي غير البعيد أو في الماضي القريب، لأتناول نبذة من سير حياة بعض المراجع الأحياء المعاصرين أو الذين لا زال مقلدوهم أحياء لليوم عسى أن يقرأ بعض مقلديهم كتابي هذا فذلك أدعى للتأثير كما أظن وأبلغ من أمثال ما نقله سماحة المجتهد السيد ميرزا حسن البجنوردي (قدّس سِرُّه) عن المقدس السيد يوسف الحكيم النجل الأكبر للمرجع الأعلى في عصره سماحة السيد الحكيم (قدّس سِرُّه) أنه كان يقول: كنّا نطبخ الباقلاء نأكلها ظهرا للغداء، ونتعشى بمائها في الليل(4). ولقد كان الإمام الحكيم يتحدث هو نفسه عن فقره هذا لخاصته وذويه، بل ويفتخر به أحيانا حيث كان يصف حاله وحال أهل بيته، بأنه في بداية حياته كان أكثر طعامهم الخبز واللبن، وهما أكثر الأشياء توفرا وأرخصها ثمنا حينذاك،(5). وقد استمر على هذا الحال من الزهد والتقشف إلى آخر عمره سواء في سلوكه الشخصي في المأكل والمسكن والمركب أم في سلوكه العائلي أم في سلوكه الاجتماعي، فقد كان الفراش يمتد
ص: 302
به العمر أكثر من ثلاثين إلى خمسين عاما ويكتفي به هو وزوجته أن يكون نظيفا طاهرا وقد كان في الملابس سواء في شكلها أم محتواها وأسلوب تقمصها ملتزما نفس المستوى والطريقة التي كان عليهما في شبابه دون تغيير.
وفي ديوان الاستقبال كان يجلس للناس متواضعا على البسط الخفيفة الأفغانية والفراش الرخيص وفي الغرفة الضيقة الجدران العادية ومن دون طلاء أو زينة والأبواب متواضعة جدا وفي طريقة استقبال الناس ولقائهم والحديث اليهم ومجالستهم. كل ذلك كان يعبر عن هذا المستوى المعيشي المتواضع الذي يدنو في مجمل تفاصيله من الفقراء ويبتعد عن الأبهة والفخامة والكبرياء. لقد كنت أشعر بأن الإمام الحكيم (قدّس سِرُّه) بسبب هذا الزهد تتولد بينه وبين الأشياء الصغيرة والبسيطة التي تحيط به علاقة ومودة، فالقلم الذي يستخدمه والساعة التي يستعملها والخاتم والعصا والدواة والصندوق المعدني المصنوع من (التنك) الذي يضع فيه الرسائل، والسرير الحديدي أو الخشبي الذي ينام عليه والسجادة التي يصلي عليها أو التي يجلس عليها وغير ذلك والصندوق الذي يحفظ فيه أوراقه أو أمواله، كلها أشياء تبقى تلازمه لفترات طويلة ما دامت قادرة على أداء الخدمة، بساطة متناهية ولطافة في الصلة، وتعبير عن الرضا بما قسم اللّه في هذه الدنيا والتجرد عن حبها أو الارتباط بها. كل ذلك والأموال تجري بين يديه والظروف مواتية، والمقام رفيع، والإنفاق على الآخرين واسع، وفرص الانتفاع أو الاستمتاع متوفرة دون حراجة، بل كان بعض حاشيته أو متعلقيه أو الطلبة الأفاضل أو مؤسساته العامة تحصل على مستوى أكثر بكثير من هذا المستوى في العيش. لقد كان زاهدا دون تكلف، حتى تحس بأن الزهد تحول إلى طبع عادي له يمارسه بين الناس وكأنه ليس منهم ودون أن يشعروا بانفصاله عنهم في زهده، ويلتزم بدون أن يشعر الآخرون بالحرج من هذا الالتزام ويربي عليه أهل بيته دون أي ضغط أو عنت(1).
ص: 303
وكان (قدّس سِرُّه) يجلس لاستقبال الناس في اليوم ثلاث مرات، مضافا إلى أيام الأعياد والمناسبات العامة، وبعد ازدياد حجم الأعمال والمسؤوليات أصبح الجلوس مرتين، و كان يجيب على الرسائل وعلى بطاقات ورسائل التهاني والتعازي(1) الواردة اليه من مختلف الطبقات فكان يرد على رسائل الواردة اليه من مستشفيات مرضى السل المنتشر و على رسائل السجناء في السجون والجنود في المناسبات المختلفة وهم كثر، حتى أنه (قدّس سِرُّه)كان لا يترك رسالة من رسائلهم إلا ويجيب عليها، التهنئة بتهنئة، والتعزية كذلك وكل المشاكل التي يطرحها الجنود يجيب عليها(2).
وحين شعر(قدّس سِرُّه) بقرب أجله يقول سماحة الدكتور الشيخ محمد حسين الصغير أرسل السيد محسن الحكيم إلى ولده السيد يوسف الحكيم أن يوافيه إلى مستشفى ابن سينا في بغداد، وسلّمه مفتاح خزانة بيت المال، فتسلمه السيد يوسف بعد تردد، وجمع لجنة مؤلفة من الأثبات والثقات، وفتحوا الخزانة، وكان كل ما فيها خمسة وثلاثين ألف دينار، قام السيد يوسف بدوره بتسليمها إلى الإمام الخوئي، فقبلها وجعلها تحت تصرفه لإعالة الفقراء وسد احتياجات الحوزة، ولو كان الإمام مليّا لما كان هذا كل ما في بيت المال، ولم يخلّف غيرها لا صفراء ولا بيضاء، وكان الناس في أيامه في عوز شديد وضائقة مالية، ولم تكن رواتب الحوزة كافية لسد الرمق، فهجرها كثيرون واتجهوا إلى الوظائف(3).
وما لنا نذهب بعيدا فهذا المرجع الأعلى للطائفة اليوم سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) على ذيوع صيته في العراق والمنطقة والعالم كله شرقه وغربه، لا زال كما عهده عارفوه من قبل هو هو في مأكله البسيط، ومسكنه المتهالك، وملبسه المعمّر الواضح القصر، وأثاثه المتواضع البسيط، زاهدا في الدنيا وزخارفها زهدا يستطيع ملاحظته بوضوح زائره المستطرق فضلا عن المطلع على دواخله الخاصة، فهو مثلا حتى يوم الناس هذا لا يملك بيتا لسكناه حيث لا زال يسكن في الدار نفسها التي عاش فيها
ص: 304
طالبا ومدرسا في الحوزة العلمية لا تتجاوز مساحتها سبعين مترا مربعا وهي مستأجرة لا يملكها، يدفع أجرتها الشهرية حتى اليوم بمبلغ متواضع(1)، بل ولا يملك ولداه المجتهدان سماحة السيد محمد رضا وسماحة السيد محمد باقر بيتا لسكناهما أيضا كما حدثني بذلك سماحته (دام ظلّه) ضمن أمور أخرى في معرض انتقاده لبعض المتقاتلين على الدنيا الدنية من طلاب السلطة الزائلة والوجاهة الزائفة خلال تشرفي بزيارته ولقائه قبل أشهر. وقد تبرع أحد المؤمنين بقيمة شراء بيت من ماله الخاص لولده المجتهد فأبى ابن المرجع الزاهد إلّا أن يقتدي بسيرة أبيه فرفض العرض.
وإذا تشرف بزيارة سماحته (دام ظلّه) يوما وقد لاحظت ذلك بنفسي مرارا مَن له أثارة من علم، أو ملحظ من دين، أو ظاهرة من ورع وتقوى قربه اليه حتى ليزاحمه في مجلسه، ولا يشغله في ديوانه كثرة الشؤون عن الاستفسار عن صحة كل قادم، شغلته الهمة العلمية عن مظاهر الدنيا، وأوقفته الظاهرة الشرعية عند حدودها، لم يعبأ بملبس أو مأكل، ولم ينظر إلى دار أو عقار، ولم يتمتع من الأصدقاء والخلصاء، ولم تستهوه مجالس الترويح عن النفس بالأحاديث والنوادر، اختص بأفراد قلائل من العلماء يستمع اليهم ويسمعون منه، لم يحضر مجلسا علميا إلا للمذاكرة، ولم يعتد المجاملات التي تستوعب بعض الوقت كل كده وجهده وكدحه خالص لعلم أهل البيت، مع وقار ظاهر واتزان معروف ونظرة صائبة. عاش فقيرا وما زال فقيرا، والملايين بين يديه لسد احتياجات الفقراء وإعلاء شأن الدين ورعاية الحوزات العلمية ومعالجة المرضى وإحياء المشاريع النافعة والإصلاح بين المتخاصمين.
عاش منعزلا حتى لا يعرفه أكثر من طلابه وعلية القوم وهو معهم وخارج عنهم، لا يتصل إلّا لماما، ولا يتعايش مع الآخرين إلا لواذا، فالعلم فوق كل شئ، وهو أكبر من كل شيء، ويضحي من أجله بكل شيء، حتى عدّ من الزاهدين في الحياة والمتفرغين
ص: 305
للعلم والعمل الصالح، بعيدا عن كل المعوقات التي تشغله عن الاشتغال والتحصيل ومتابعة المعارف.
إذا حضر محفلاً علمياً بدأ بالبحث العلمي، أو اجتمع بصديق له عرض عليه مسألة مشكلة للتوصل إلى حلول، وإذا أدى واجبا اجتماعيا اقتصر على إسقاط الغرض دون التبذير بالزمن. فيه بساطة الأتقياء، وعليه سيماء الصالحين، ولديه فكر المتيقظ الحذر، وعنده الخبرة الكافية بمعاصريه كما هي في الرجال ومدارك التعديل(1).
وقد حدثني رئيس الجمهورية العراقية مام جلال الطالباني يوما بانبهار وقد عاد لتوّه من زيارة سماحته في النجف الأشرف، كيف أنه سرد له تفاصيل عن آباء مام جلال وأجداده وأهل مدينته متحدثا بإلمام عن مدى اهتمامهم بالعلم والفضيلة في كردستان ما يشير إلى سعة اطلاعه على أحوالهم ومبالغ مستوياتهم، وإلمامه بخصوصيات طرائقهم وشؤونهم.
وهناك الكثير الكثير مما أعرفه عن زهد سيدنا المرجع الأعلى (دام ظلّه) ولا أقوله، خشية أن لا يرضى من نشر ما أعرفه عنه على الملأ وهي طريقة درج عليها الصابرون الزاهدون المتقون تقبل اللّه أعمالهم ووفقنا للاقتداء بهم إنه أرحم الراحمين.
ثالثاً: وإذا كان حال مراجع التقليد كما عرضته فإن وضع طلابهم من طلاب الحوزة الورعين المجدين الحريصين على نيل رضا اللّه جل وعلا وحبه بأحسن من وضع مراجعهم وأساتذتهم والمجتهدين، فقد كتب سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين عن بداية حياته الدراسية في النجف الأشرف قائلا: كنت إذ ذاك في بداية الشباب، وفي ذروة الحياة الدراسية في النجف الأشرف وحلقاتها العلميّة، حيث الفقر حينذاك والحاجة إلى حدّ الجوع، وطيّ الليالي والأيام بلا طعام. وحين يتيسّر الطعام فهو غالباً
ص: 306
طعام بسيط، فقد كان الشبع من الطعام الجيّد ترفاً نادراً، وحيث البحث في ليالي الجوع الظلماء عن نفايات الخبز في شرفات غرفة الطلبة في المدرسة، وهي نفايات قليلة فأغلبهم أيضاً فقراء، وان لم يبلغوا في فقرهم حدَّ الجوع وقلما كانت تُتاح الفرصة للحصول عليها، لغلبة الحياء، وخوف انكشاف الحال، فتغسل مما علق بها من تراب وتنقع في الماء لتلين... وحيث النوم بلا وطاء أو بلا غطاء، وحيث الثياب الممزَّقة المرقَّعة، ولبس ثياب الصيف في الصيف والشتاء في بعض السنين، ولبس ثياب الشتاء في الشتاء والصيف في سنين أخرى... وحيث الحفاء في شكل الاحتذاء، أو الاحتذاء الشبيه بالاحتذاء... والحمد للّه على نعمته لقد كانت أياماً مباركة، رزقنا اللّه فيها الصبر، وكانت قسوتها تربية وترويضاً وإعداداً لما أراده اللّه اللطيف بعباده...كانت حياةً قاسية، وكان الملاذ من كل ذلك إلى الدرس والقراءة وزيارة أمير المؤمنين علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) ومسجده...
رابعاً: ومن إيجابيات النظام الحوزوي أيضا انه نظام تطوعي، فالمرجع حين يتحمل مسؤوليات الإفتاء إضافة إلى أعباء الحوزة ومسؤوليات الأمة، والمدرس حين يجهد نفسه في التعليم وتوصيل المعلومات بشغف وتعب محبب منذ الصباح الباكر وحتى المساء تطوعا، والطالب حين يبذل قصارى جهده في التعلم والبحث والمتابعة واستفراغ الوسع في المعرفة شادا الرحال غالبا من مسقط رأسه إلى حيث النجف الأشرف، متحملا أعباء الغربة ومشاق الضنك الاقتصادي، والمبلِّغ حين يعاني ما يعاني من أجل إيصال رسالته إلى الناس متنقلا بين الدول والمدن والأقضية والنواحي والقصبات دائرا بعلمه وهمّ إيصاله إلى الناس متحملا عن طيبة قلب كل ما يعترضه من جهود وآلام. إن كل هؤلاء لا يبغون ولا يريدون من أحد من الناس جزاء ولا شكورا.
ولقد كنت أرى شدة حراجة الأستاذ في رفض أي طلب يأتيه من طالب يريد أن يدرس عنده مادام يملك وقتا يمكن أن يفرغ نفسه فيه لتلبية رغبة الطالب ولا
ص: 307
أقصد بشدة حرج الأستاذ وقلق ضميره وتقليبه لساعاته وأوقاته غير الحرج الشرعي والأخلاقي، فهو يخشى إن تقاعس أو تكاسل في إجابة الطلب بالإيجاب مع سماح ظروفه بذلك أن يساءل غداًيوم لا ينفع مال ولا بنون عن سبب رفضه أو يسائله ضميره عن علة رفضه ما دام قد وطن نفسه بنفسه على سلوك هذا الدرب وتحمل تبعاته وأتعابه.
خامساً: إن الطالب في الحوزة العلمية النجفية لا يتوخى من وراء دراسته الحوزوية وظيفة مادية أو منصبا تنفيذيا أو رتبة اجتماعية أو وسيلة اقتصادية أو غاية سياسية أو غيرها، بل لا يسعى أيضا إلى الحصول على شهادة بالتخرج تتيح لحاملها ما تتيحه الشهادات ووثائق التخرج من فرص عمل وأشباهها، ولذلك فإنك لا تجد الطالب الحريص على مستواه العلمي في الحوزة يهرول كي يقطع الطريق إلى نهايته سواء استوعب ما درسه أم لم يستوعبه، بل كثيرا ما كنت أرى من الطلاب من أتم دراسة كتاب ما ثم حين فرغ منه فحص نفسه فوجدها لا زالت غير هاضمة ما درسته هضما يطمئن قلبه له، فقرر عندها العودة إلى كتابه ثانية لدراسته واستيعابه وأقول الطالب المخلص المجد الحريص على مستواه العلمي إخراجا لمن تزيى بزي رجال الحوزة العلمية لغرض في نفس يعقوب.
سادساً: إن لغة التدريس في جميع مراحل الدراسة في الحوزة العلمية النجفية منذ تأسيسها قبل ألف عام وليوم الناس هذا هي اللغة العربية الفصحى. وإن أدنى ملاحظة للمنهج التدريسي المتبع فيها ولغة تدريسه وكتبه الدراسية وأساليب طرحه وغيرها وكلها عربية فصيحة كما تقدم تثبت بوضوح هذه الحقيقة. بيد أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم وجود من يدرّس بغير هذه اللغة في هذا المسجد أو ذاك أو في هذه الحلقة الدراسية أو تلك لوجود أعداد غير قليلة من غير العرب في الحوزة مما قد يضطر معه الأستاذ إلى الاستعانة بلغته الأم أو بلغة الطالب الأم لإيصال المعنى المقصود بدقة
ص: 308
متناهية إلى تلميذه وبخاصة إذا كانت مادة البحث عميقة وهي غالبا ما تكون كذلك.
يقول المجتهد الشيخ محمد تقي الفقيه في كتابه الذي كتبه عن النجف أيام دراسته فيها خلال منتصف القرن الرابع عشر الهجري مؤكدا هذه الحقيقة بما نصه: التدريس في النجف باللغة العربية، ويتقصد الأستاذ الفصحى طاقته، وقد يتنزل عنها طمعا في الإفهام والتوضيح أو من جهة غلبة.العادة. هذا بالنسبة للدروس العليا وللمدرسين من العرب، أما الإيرانيون والأفغانيون والهنود والتبتيون والنكر وغيرهم فإنهم يلقون الدروس السطحية باللغة العربية، ثم يترجمونها لتلاميذهم بلغاتهم، حتى إذا أتقنوا العربية يصبح الدرس كله باللغة العربية. أما دروس الخارج فكلها بالعربية، وقد يضطر الأستاذ لغيرها في أثناء الدرس(1) للتوضيح كما سبق.
إن هذه الخصيصة المهمة في حوزة النجف الأشرف كانت نتيجة طبيعية لطبيعة التركيبة السكانية لمدينة النجف الأشرف الحاضنة للحوزة العلمية فمدينة النجف ذات شمائل عربية، والطابع العام لسكانها هو الطابع العربي بنخوته وعشائريته ورعايته للجار وكرمه وحبه للضيف والضيافة وأمثال ذلك مما يتميز به العرب خلال تاريخهم الطويل ولعل السر في ذلك أن النجف تقع بين الريف العراقي المنتشر على ضفاف الفرات وبين البادية الممتدة من العراق إلى الحجاز، وهي السوق المشتركة بين عشائر الريف وعشائر البادية، وهذه الصلة الاقتصادية بين طرفي الريف والبادية وبين النجفيين هي التي طبعت النجف بهذه السمات(2).
وهناك خصيصة أخرى كان للخصيصة السالفة دخل فيها، وهي تميز النجف عن غيرها من مدن العراق، انها لكونها مدينة جامعية للدراسات الإسلامية وتمتد جامعيتها على مدى يقرب من عشرة قرون قد احتفظت باللغة العربية وآدابها رغم كل محاولات (التتريك) الذي فرضه المماليك والحكام العثمانيون على مدارس العراق وغيرها من
ص: 309
البلدان الخاضعة للخلافة الإسلامية من جهة ورغم انتشار اللغات الشرقية وبخاصة اللغة الفارسية بين الوافدين اليها من أقطار العالم الإسلامي التابعة لمرجعيتها الدينية من جهة ثانية. ولعل السر في احتفاظها باللغة العربية وآدابها أن الدراسة الدينية واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها تعتمد بصورة أساسية على مصادر هي نصوص عربية أصيلة بلغت الغاية القصوى في فصاحتها وبلاغتها وأهمها القرآن الكريم والسنة النبوية ونهج البلاغة وآثار أئمة أهل البيت،. من أجل ذلك لم يكن غريبا أن يتشدد الأصوليون في شروط (الاجتهاد) فيذكروا فيها أن يكون المجتهد على علم باللغة وفهم أساليب العرب، ولذلك كانت الدراسة الدينية تبدأ عادة بما يسمى (المقدمات) أو (علوم الجادة) وأهمها النحو والصرف والبلاغة وفيها من البحوث النحوية والصرفية والبلاغية ما لا يوجد في كتب النحاة والبلاغيين، وهذا هو السر في أنك تجد أكثر من نبغوا في أوائل هذا القرن من أدباء العربية وشعرائها وأصحاب الخبرة في فلسفتها اللغوية هم من خريجي مراكز الدراسات الدينية(1).
ولقد كان من نتائج احتفاظ حوزة النجف الأشرف بلغتها العربية الفصحى وحرصها الشديد عليها وتأكيدها المستمر عمليا على استعمالها في المنهج والدرس اليومي كتابا ولغة تدريس وأسلوب كتابة ولغة مباحثة ونقاش وحوار علمي تعريب المسلمين القادمين إلى تلك الحوزة من الصين ومنغوليا وأزبكستان وأفغانستان والهند وتركيا وإيران ومثل هؤلاء الطلاب من غير العرب يعودون إلى بلادهم وهم علماء نحو وصرف وبلاغة كما هم علماء دين.
وغير خفي ما لمثل ذلك من أهمية في نشر اللغة العربية فإنما يعودون وهم يشعرون بشيء غير قليل من الفخر والزهو لأنهم يعرفون العربية ويقرؤون القرآن ويفهمون كتب التاريخ الإسلامي والعربي بلغتها العربية وقد ينقلون ذلك لأبنائهم في تلك
ص: 310
البلدان الأجنبية كما هي حالة غير المتعلمين العرب الآن في الجامعات الأوربية.
وإذا ما علمنا أن اللغة العربية لم تلق من الإعراض والإهمال في تاريخها الطويل ما لاقته من القرون المتأخرة قبل (ما أطلق عليه) عصر النهضة عرفنا بعض ما أسدته الحوزة العلمية في النجف إلى لغة القرآن الكريم(1) و آداب اللغة العربية وبخاصة الشعر العربي من فضل.
ولئن ناضلت جامعة الأزهر القاهرية ضد العامية والإنكليزية وحمت جامعة الزيتونة في المغرب اللغة العربية من همة البربرية والفرنسية والإيطالية، فجامعة النجف حرست العربية من غزو بضع عشرة لغة استطاعت أن تجتاح العاصمة بغداد ثم الموصل والبصرة(2).
ولم تكتف الحوزة العلمية النجفية بدورها في الحفاظ على بقاء اللغة العربية وديمومتها ونقائها وصونها من محاولات الإلغاء والتهميش والتحريف والتغريب فقط، بل تعدت ذلك إلى تحمل مسؤولية نشر العلوم في العراق وبث المعارف وتوعية العراقيين بضرورة وأهمية التعلم وتهيئة الوسائل الكفيلة بتحمل ذلك كله بما لا يقاس بما كانت تقوم به وتتحمله الدولة وأجهزتها التنفيذية بمدارسها ومعاهدها ومؤسساتها وبخاصة في العقود الأولى من القرن الماضي فالمدارس الرشيدية (التي تعادل الدراسة المتوسطة اليوم) لم تكن لتضم أكثر من (360) ثلاثمائة وستين طالبا في جميع أنحاء العراق موزعين على عشر مدارس، في حين أن الحوزة العلمية في النجف وحدها في ذلك العصر كانت تضم ما يقارب من عشرة آلاف طالب.. والفرق بين العشرة وبين (360) فرق كبير ويستوقف الباحث حتما إذا وضعنا كل تلك الحقائق نصب أعيننا، وأدركنا جليا أهمية الحوزة العلمية في رفع المستوى الفكري والعلمي والحضاري للأمة في عصور التجهيل، وأدركنا كم للحوزة من دور فاعل في الحفاظ على التراث العلمي
ص: 311
للأمة الإسلامية(1).
سابعاً: إن الطالب المشتغل في الحوزة العلمية النجفية وفي الحوزات الدينية كلها هو طالب لمن هو أعلى منه طبقة علمية لا عمرية، وهو في الوقت نفسه أستاذ لمن هو دونه طبقة علمية في آن واحد وهكذا تتسلسل المراتب العلمية وتتنوع مهام رجالات الحوزة بين أستاذ آنا وطالب آنا،آخر أستاذ لمن هو أدنى منه مرتبة، وطالب عند من هو أعلى منه مرتبة. وقد استطاعت هذه الطريقة التربوية تحقيق نجاحات عملية متميزة فهي تتكفل بتوفير الأساتذة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية كما تتعهد بتدريبهم وإعادة تدريبهم باستمرار، كما أنها تعيد تنشيط ذاكرة الأستاذ بما سبق أن درسه وتجاوزه من مواد دراسية معقدة وكثيرة التفرعات مما يبقي تفاصيل المعلومات السابقة حاضرة في الذهن باستمرار إضافة إلى بعدها الأخلاقي المهم فالأستاذ مهما تقدم في مستواه الدراسي يبقى طالبا للعلم والحقيقة ولنتيجة البحث.
ثامناً: إن الأستاذ أو الطالب في الحوزة العلمية النجفية، بل المرجع نفسه غير مستنكف من أن يقول لا أعلم، وغير آبه من أن يقول سل فلانا مثلا، أو حتى سل ابني عما سألتني عنه فإنه أذكر مني، بل ولا متحرج وهو المرجع من أن يعترف بخطئه فيما قاله متى ما انكشف له أنه مخطيء فيما قاله، وقد حدث ذلك معي أكثر من مرة، ويتجلى هذا الأمر بشكل أوضح فيما أورده الباحث جعفر الخليلي متحدثا عن المرجع سماحة الشيح محمد الحسين آل كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه) حين قال: ولم أجد شخصا يعدل عن رايه بالسرعة التي يعدل الشيخ محمد الحسين عن رأيه حين تتضح له الحقيقة، ويتجلى له الحق، وكثيرا بل وأكثر من الكثير الذي رايت فيه الإمام يدلي برأي خاص كان يؤمن به منذ زمن ثم لم يكتف بتغير رايه، وإنما راح يدل الآخرين على المواطن التي لم يصب فيها من قبل، وإذا تبجح الكثير بما قد أصابوا في كثير من الآراء فإنه ليسرد لك في المناسبة
ص: 312
كثيرا من المواقف التي التبس فيها عليه الأمر. وهي صفة لزبدة العلماء المحققين(1).
ولقد بات من المتعارف عند الحوزويين، بل الواجب عليهم أن يتحروا عن سائلهم ليقولوا له معتذرين : أنهم أخطأوا في جوابهم عن مسألته التي سبق أن سألهم عنها سابقا وان الصحيح في جواب المسألة هو كذا وكذا.
ولقد تعود الناس أن يسمعوا بإلفة جميلة قول أستاذ مشهور من أساتذة الحوزة، بل أن يسمعوا من مرجعهم المقلد نفسه أحيانا كما حدث لي أكثر من مرة أنه غير مستحضر للجواب الساعة، وأن عليه أن يراجع ويبحث في المسالة لكي يجيب.
تاسعاً: إن الأستاذ الواقعي في الحوزة العلمية النجفية لا يجد غضاضة في أن يقول إن الأستاذ الفلاني أعلم مني، أو أن درس فلان أنفع من درسي وما شابه، لأن رضا اللّه عز وجل هو الهدف، وطلب الحقيقة وقولها هو المقصد. ولقد كنت أشاهد حينا وأسمع أحيانا من ذلك قصصا وحكايا عن بعض من عاصرت من العلماء الصالحين يقول بملء فيه إن فلانا أعلم مني فاقصده وسله عن مسألتك وما شابه، كما أثبت لنا المؤرخون قصصا وحكايا مشابهة أسرد بعضها كشاهد على ما أدعي.
من ذلك مثلا أن المرجع الأعلى في عصره سماحة الشيخ الوحيد البهبهاني مجدد القرن الثالث عشر المتوفى عام 1205 ه / 1791م اعتزل المرجعية في أواخر عمره وأناط مسألة التقليد بأبرز تلامذته، وقد نقل لي أحد كبار المراجع في النجف الأشرف أن الوحيد قلّد الشيخ جعفر الكبير بعد إحساسه بضعفه في الاستنباط، وأخذ يدرّس شرائع الإسلام للمحقق الحلي على سبيل الاستحباب(2) وهو كتاب يدرسه الطلبة في مرحلة المقدمات.
ومنها ما نقل عن السيد حسن كوهكمري - وهو من أساتذة الحوزة العلمية النجفية
ص: 313
المعاصرين للشيخ مرتضى الأنصاري (قدّس سِرُّه) أيام كان الشيخ الأنصاري لا يزال بعد غير معروف - من أنه حضر في أحد الايام قبل طلبته إلى محل درسه، فرأى في أحد أركان المسجد شيخا غير معتنٍ بهندامه جالسا مع عدد من الطلبة مشغولا بالتدريس، فأصغى السيد كوهكمري لكلامه فأحس أن هذا الشيخ يدرّس بصورة تحقيقية ويبحث بصورة عميقة. فرغب في اليوم اللاحق أن يحضر إلى المكان في وقت أبكر ويستمع إلى الشيخ، فحضر فازداد اعتقاده بالشيخ وازداد يقينا بأن هذا الشيخ أفضل منه وأعلم، ولو أن تلاميذه حضروا درس هذا الشيخ بدل الحضور في درسه لكانت استفادتهم أكثر، ولهذا عندما حضر تلامذته في اليوم اللاحق قال لهم: إخواني إن هذا الشيخ الجالس مع بعض الطلبة في ناحية المجلس أفضل مني تدريسا وأصلح، وأنا أيضا أستفيد منه، فلنذهب جميعا إلى درسه. منذ ذلك اليوم حضر السيد حسين كوهكمري وطلبته درس الشيخ الأنصاري(1)
ومنها مثلا أن المرجع الأعلى في عصره سماحة الشيخ محمد حسن النجفي (قدّس سِرُّه) صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام المتوفى عام 1266ه/ 1850م حين حضرته الوفاة وجمع العلماء ليقلد الشيخ مرتضى الأنصاري أمر المرجعية العليا بعده في قصة معروفة تأتي في الباب الخامس عشر من هذا الكتاب تريث الشيخ المرشح في قبول الترشيح أول الأمر قائلا: أنا لست الأعلم ظانا أن هناك من هو أعلم منه ولو في دولة أخرى، وهكذا بقي متريثا ولم يستقر له بال حتى كتب إلى المجتهد الذي ظن أنه أعلم منه ليتولى أمور المرجعية وهو سعيد العلماء المازندراني (قدّس سِرُّه)، فراسله في ذلك وعرض عليه الأمر ف كتب سعيد العلماء المازندراني في جواب على رسالة أرسلها له الشيخ الأنصاري يخبره فيها بتقديمه إياه على نفسه في المرجعية وزعامه المسلمين لأنه أعلم منه : أجل الأمر كما تفضلتم،وذكرتم، وكنت أعلم وأدق حينما كنت هناك
ص: 314
مشغولا بالدراسات لكن هناك شيء ميّزك عني : وهو استمرارك في الاشتغال بالبحث والتدريس والتأليف والتصنيف، وتركي البحوث والدروس لاشتغالي بمهام الأمور من حل القضايا وفصلها، فأنت أعلم مني، فالواجب على الطائفة تقليدك وتسلّمك أمور الزعامة والمرجعية(1).
وإذ قرأ الشيخ الأنصاري جواب رسالته قامت البيِّنة الشرعية عنده على أعلميته، فتقبل هذا التكليف الإلهي والمسؤولية الخطيرة(2).
ومن ذلك مثلا : أن السيد علي التستري أو الشوشتري على اختلاف بين مترجميه المتوفى سنة 1281 ه/ 1864م(3) أستاذ الأخلاق في حوزة النجف الأشرف كان يحضر دروس الشيخ مرتضى الأنصاري في الفقه والأصول، فيما كان الشيخ يحضر دروس السيد التستري أو الشوشتري في الأخلاق كل أسبوع ويدعو طلابه لحضور هذا الدرس والتزود من ثماره المعنوية وإزالة الصدأ عن القلوب، وهذه من الحالات النادرة في التأريخ حيث تجتمع التلمذة والأستاذية لأحد تجاه آخر، فالشيخ كان أستاذ السيد في الفقه والأصول وتلميذه في الأخلاق(4).
ومنها أن المرجع الشيخ عبد الكريم الحائري المتوفى سنة (1355ه/ 1936م) كان يلقي دروسه المعتادة في الوقت نفسه الذي يلقي فيه المجتهد الشيخ محمد القمي المتوفى سنة (1341 ه / 1923م) درسه المعتاد أيضا، وفي يوم من الأيام قال الشيخ القمي لطلابه:
تحدثنا في الدروس الماضية عن موضوع (الأهم والمهم) بشكل مفصل وهو موضوع يبحثه أساتذة الحوزة العلمية ضمن منهجهم الدراسي المعتاد واليوم أريد أن أقول لكم بأن حضوركم في دروس الشيخ الحائري أهم من حضوركم دروسي،فاذهبوا
ص: 315
يا أعزائي واحضروا دروسه.
فنهض جميع الطلاب إلا اثنين منهم، وهما (الشيخ محمد تقي القمي والشيخ محمد باقر القمي) ابناه، فقد كانا راغبين بحضور دروس أبيهما، فكرر عليهما الشيخ قوله مخاطبا إياهما بلغة الأب والأستاذ معا إذهبا إلى دروس آية اللّه الحائري. وهناك من غير هذه الأمثلة كثير.
عاشراً: انعدام فارق السن بين الطلاب في حلقة الدرس الحوزوي، فقد يحدث أن تجد في حلقة الدرس الحوزوي من طلابها من هو بمنزلة الابن إلى جنب من هو بمنزلة أبيه سناً، وسمةً ومقاما ووقارا، وكلاهما غير مستنكر لهذا التفاوت في العمر، ولا مكترث به، ما دامت تجمع الشيخ والشاب المرحلة الدراسية الواحدة عينها. ولطالما شاهدت بأم عيني ذلك في حلقات الدرس المنتشرة في الجوامع وأماكن الدراسة، بل بات من المألوف أن تشاهد طالبا أكبر سنا من أستاذه وهو جالس بحضرته متأدبا تأدب المتعلم أمام العالم يستمع إلى محاضراته وتوجيهاته العلمية والتربوية.
وقد تجد الأستاذ والطالب معا يدرسان في حلقة دراسية واحدة موضوعا من الموضوعات أو يتلقيان علما من العلوم رغب كل منهما أو احتاج لأن يتعلمه أو يستزيد منه، وربما صادف أن شجع أحدهما الآخر عليه، فترى الأستاذ والتلميذ معا قادمين إلى درسهما المشترك متصاحبين أو ذاهبين عنه مترافقين ربما إلى حلقة درسٍ آخر أحدهما الأستاذ فيه والآخر التلميذ وهكذا.
وقد دوّن الدكتور محمود المظفر في ذكرياته عن مرحلة دراسته الحوزوية الأولية أنه سجل في دورتين دراسيتين، أولاهما لتعلم العلوم الرياضية، وثانيهما لتعلم اللغة الإنكليزية فتحتهما جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف في الخمسينات من القرن
ص: 316
الماضي للمبتدئين في تحصيل هذه العلوم العصرية وقد توجّه للانضمام اليها كذلك بعض من أساتذة كلية منتدى النشر أمثال الأستاذ الراحل محمد صادق القاموسي الذي بادر إلى التسجيل في كل من دورة الرياضيات العامة واللغة الإنكليزية والذي ظل مواظبا على الحضور فيها، والأستاذ الحجة الحكيم (السيد محمد تقي الحكيم) الذي انتمى ولو لمدى محدود إلى دورة اللغة الإنكليزية، وأكشف الآن هذه الحقيقة للتدليل على ما كان يتمتع به الأستاذ الحكيم والأستاذ القاموسي ونظراؤهما من تفتح ذهني عال وواقعية وتواضع جم، دون أن يجدا حرجا في الجلوس إلى جانب طلابهما من أجل التزود ببعض متطلبات العصر الحديثة(1).
ثم زاد الدكتور المظفر الطالب آنذاك عند أستاذيه المتقدم ذكر هما السيد محمد تقي الحكيم والحاج محمد صادق القاموسي فأضاف ثم لا أكاد أنسى وقد واتت الفرصة لذكره أن السيد الحكيم كان في تلك الفترة يشارك أيضا بعض طلابه وأنا من بينهم في مشروع شراء ما بدأ يرد آنذاك إلى النجف من القاهرة وبيروت بعد فترة انقطاع من كتب وصحف ومجلات دورية تشجيعا لطلابه في التزود من منابع الثقافة الحديثة(2).
أما على صعيد مرحلة البحث الخارج فقد كان سماحة عمي المجتهد المغفور له السيد محمد حسين الحكيم (قدّس سِرُّه) يحضر (حضورا تيمنيا) كما يصطلح عليه الحوزويون في دورة بحث جديدة، كان انتهى من حضورها سابقا جنبا إلى جنب مع تلميذه أو من هو بطبقة تلميذه في درس بحث الخارج الذي يلقيه أستاذهما معا سماحة المجتهد المحقق الشيخ حسين الحلي (قدّس سِرُّه) عصر كل يوم من أيام التحصيل العلمي في إحدى غرف الصحن الحيدري الشريف. وكذلك كان يفعل والدي (قدّس سِرُّه) وغيرهما من أمثالها العديد العديد، ذلك أن هذا الحضور مع عدم الحاجة العلمية اليه يكاد يكون عرفا حوزويا قائما.
ص: 317
حادي عشر: إن الهدف من الحوار العلمي وارتفاع وتائر الصوت حدة بين المتباحثين أستاذا وطلابه أو باحثا ومناقشيه عادة هو من أجل الوصول إلى الرأي المختار، لا من أجل كسب الجولة، وهو ما قد يخفى على غير المعتادين عليه حتى ليظن الناظر إلى المتباحثين أو المنصت لهما أنهما لا يتباحثان وصولا إلى الحقيقة وهو الهدف الأسمى للنقاش وارتفاع وتائر الصوت بل يتنازعان أو يتماحكان في قضية شخصية يريد كل منهما كسبها لصالحه كي يستفيد أو يكسب أو ما شاكل، حتى إذا انتهى البحث المسألة العلمية عادت لغة المحبة والود وعاد معها الهدوء والصفاء للمتناقشين. وخيم الكلام الرقيق على مجلس البحث بعد أن اقرّ أحد المتناقشين بخطئه واعترف واثقا من نفسه بسهوه أو غفلته إن إلفة النجف لهذا النوع من الجدال والصراع ضمن حياتها العلمية الطويلة أكسبها في بحوثها العلمية صفة الموضوعية والتواضع وأبعدها عن مستلزمات الجدل العقيم الذي يورث غالبا الصفات الذميمة كالتحاقد والتباغض والتمسك والاعتداد بالرأي، وإن وضح لدى صاحبه جانب الخطأ فيه، وهذه الصفات البغيضة إنما تتوفر غالبا في أصحابها إذا كان مبعث الجدل هو الحصول على منفعة ذاتية أو كان منبعثا عن عقدة نفسية متأصلة في صاحبه، أما إذا كان بلوغ الحق هو رائد الجميع، وكانت الفكرة هي مجال الأخذ والرد منفكة عن أصحابها، كانت الموضوعية وسرعة التنازل للحق هي المالكة لزمام الجدل في أغلب المتجادلين(1).
ثاني عشر: إن الدراسة في الحوزة العلمية النجفية تبدأ منذ الصباح الباكر من قبل طلوع الشمس أحيانا، وتستمر حتى وقت ما من الليل تتخللها فترة راحة الظهيرة التي يفرضها عليهم الجو الطبيعي الحار الملتهب في النجف الأشرف أشهر الصيف، والمترب غالبا أسأبيع الربيع. فحين تزور جامع الهندي في النجف الأشرف مثلا تجد على مدار الساعات المشار اليها حلقات درسية تختلف عددا وكمّا من آن لآخر حسب الأستاذ
ص: 318
ومادته.
وقد حدثني سيدي الوالد (قدّس سِرُّه) في معرض حديثه عن دراسته أنه اتفق في مرحلة ما من مراحل دراسته مع أستاذه أن يذهب إلى دار أستاذه مبكراً نتيجة ازدحام جدولهما الدراسي اليومي، فيوقظ أستاذه لصلاة الفجر ثم يبدأ درسه بعد الصلاة مباشرة، وليس هذا هو حال سيدي الوالد وحده إنه حال العديد من طلاب الحوزة العلمية النجفية أمس واليوم أيضا. يقول الشاعر محمد جواد الغبان طالب الحوزة العلمية في النجف الأشرف سابقا أثناء دراسته لكتاب (شرح التجريد) للشيخ الطوسي لقد رجوت من أستاذي الشيخ محمد رضا المظفر ان يدرسنا هذا الكتاب وكنا ثلاثة طلاب فقط، فاعتذر الأستاذ لعدم وجود الوقت لديه لمثل هذا العمل. وبعد الحاحنا عليه، ورغبتنا في طلب العلم، وافق الأستاذ على ان يدرسنا الكتاب بين الطلوعين (الفجر والشمس) فهو الوقت الوحيد الفاضل لدية لالقاء الدروس. وهكذا كنا نخترق أزقة النجف المظلمة قبل الفجر كل يوم أنا والسيد علي الصافي ومحمود المظفر لحضور الدرس، حتى أكملنا دراسة الكتاب(1).
ثالث عشر : إن الأستاذ والطالب في حوزة النجف الأشرف هما دوماً في امتحان علمي مستمر في أدق المسائل تارة وفي أيسرها،أخرى لاختبار معلوماته تارة أو للحاجة إلى جوابه أخرى، وعليه،لذلك مختلفة، تحقيقا للقربة وتحصيلا للثواب مرة، أو إثباتا للقدرة وتدليلا على الموهبة أو إثباتا للوجود أو دفعا للانتقاص أو تخلصا من الشفقة، أو لغير ذلك فإن على الحوزوي دائما أن يكون متسلحا بالمعلومة ومستعدا للإجابة عن كل ما يسأل عنه فيما درس ودرّس في كل آن، سواء أكان ذلك في مجلس علمي اجتماعي عام أم في غيره، وسواء أكان خلال الدرس أم خارجه من أستاذه كان أو من زملاء مباحثته، في البيت وجه اليه السؤال أم خارجه، في جلسته مع أسرته أم في سواها، في
ص: 319
الصباح بادره السائل أم في المساء وهكذا. وهو ما يحثه باستمرار على التزود بالمعلومة واستمرار البحث والتحصيل والمذاكرة والاستحضار والمراجعة والحفظ.
رابع عشر: إن الطالب المشتغل الحريص على نيل رضا اللّه عز وجل الساعي للتزود بالعلم والمعرفة استجابة له قادر باندفاع ذاتي كبير بل بحب على تحمل الظروف الحياتية القاسية والمعاناة الشديدة والمكابدة المرة والطوارئ الحاصلة كي يواظب على حضور درسه و تدریسه و مباحثته وتحصيله متجاوزا الصعوبات ومتخطيا العوائق وقد ضرب لنا بعض طلاب وأساتذة حوزة النجف الأشرف أمثلة نادرة لشدة المواظبة وعدم الانقطاع عن التحصيل في أشد الظروف وأقساها من ذلك مثلا ما نقله سماحة الشيخ محمد رضا المظفر (قدّس سِرُّه) عن حياة أستاذه الكبير سماحة الشيخ محمد حسين الأصفهاني العلمية وسيرته الدراسية فترة تتلمذه على يد أستاذه الكبير سماحة الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخوند الخراساني (قدّس سِرُّه) وكيف أنه أختص به ولازم أبحاثه طيلة ثلاث عشرة سنة وكيف أنه لم يترك درس أستاذه هذه المدة إلا يومين: يوم أصيب فيه برمد شدید عاقه عن الحضور، ويوم آخر هطلت فيه الأمطار بغزاره فظن أن ذلك سيعوق أستاذه وتلاميذه عن الحضور، فظهر بعد ذلك أن أستاذه حضر وألقى درسه على شرذمة قليلة منهم(1).
وفي حالة مشابهة كتب سماحة المرجع الأعلى في زمنه سماحة السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) في مقدمة تقريراته لكتابة تلميذه سماحة السيد علي الشاهرودي عن محاضرات أستاذه أن تلميذه هذا لم يغب عن حضور درس أستاذه المرجع مدة عشرين عاما متواصلة.
بيد أن ذلك لا يعني غلبة هذه الظاهرة على الطلاب ولكن وجودها في حدّ ذاته مؤشر تربوي جدير بالاهتمام
ص: 320
خامس عشر : إن الحوزة العلمية النجفية مستقلة في قرارها السياسي والثقافي والمادي وغيره الاستقلال كله ومستقلة أيضا في إدارتها الذاتية ومنهجها التعليمي ومواردها التي تعتمد على خالقها أولا وعلى الدعم الشعبي للمؤمنين من خلالالحقوق الشرعية والهدايا والهبات التطوعية ثانيا.
وإذا كانت السلطات الرسمية قد حاولت مرارا التدخل في الشأن السياسي أو المادي للحوزة العلمية في النجف الأشرف ففشلت، فإن تاريخ الحوزة العلمية النجفية هو الأخر لم يشهد حالة ما لتدخل رسمي في نظامها التربوي، منهجا أو طرائق تدريس أو شبهه، أيا كانت جهته، وأيا كانت الضغوط المصاحبة له.
ان الحوزة العلمية لا تشترط شهادات لمنتسبيها ولا تمنح شهادات أو وثائق لخريجيها ولا تسعى ولا تبحث ولا تريد من أية جهة رسمية أو غير رسمية أكاديمية أو غير أكاديمية الاعتراف بها، بل إن الحوزة تنأى بنفسها عن ذلك النأي كله. لعدم احتياجها اليه من جهة، ولمعرفتها بالمستوى العلمي الرصين لطلابها الذي غالبا ما يفوق مستويات من يمنح الشهادات للطلابفي بعض الجامعات ذات الاختصاص المشابه من جهة أخرى، ولغير هذه وتلك ثالثة.
هذا وقد أوجز سماحة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه) بعضا من أهم إيجابات هذه الدراسة خلال إجابته عن سؤال وجهته اليه فكتب لي معددا من إيجابياتها ما يأتي:
أولاً : لا تتقيد الحوزة بنظام حدّي في تحديد مراحل الدراسة، بل كل شخص يعمل بقناعاته وقابلياته في إطار الحوزة العام، بحرية تامة وحسب القدرات المتاحة له، من دون أن يتقيد بجدول زمني خاص ولا بأستاذ خاص ولا بغير ذلك، حيث يتيسر له
ص: 321
بذلك استغلال قابلياته وملكاته على أتم وجه، كما يقتضيه الواجب الشرعي في تحقيق الحق للخروج عن عهدة التكاليف الإلهية المقدسة، وبراءة الذمة منها.
وثانياً: عدم خضوع الحوزة للسلطة القاهرة التي تتحكم في قبول الأشخاص في الحوزة، وفي تشخيص من يبلغ المراحل المتعاقبة فيها من المرحلة الأولى حتى المرجعية العظمى، بل لكل أحد الدخول في الحوزة والمعيار في أهليته لها ومرحلته فيها دينياً وعلمياً على القناعات الفردية للناس، نتيجة الاحتكاك بالشخص وتقييم الأشخاص الموثوقين له، في علمه ودينه، وقابليته الشخصية في الظهور على الساحة وفرض نفسه على الناس، والتحكم في قناعتهم المبنية في الإطار العام على الواقعية والإخلاص، من دون نظام محدد لذلك.
وثالثاً : تستقل الحوزة مادياً عن الدولة وعن غيرها من ذوي النفوذ، بل تعتمد بوجه عام على الحقوق الشرعية التي يدفعها المؤمنون بوجه طوعي قياماً بالتكليف الشرعي من دون قيد ولا شرط ولا نظام يتيسر التحكم فيه.
وقد كان لهذه الأمور بعد تسديد اللّه تعالى ورعاية صاحب الأمر عجل اللّه تعالى فرجه أعظم الاثر في محافظة الحوزات على بهائها وقدسيتها، وعلى تكامل العلم وتطوره وعمقه فيها.
وكان فيها علماء بالمستويات العليا في العلم والتحقيق والعمق، وفي الإفادة والإنتاج، ولهم أعظم الأثر في رفع المستوى العلمي في الحوزات، والصعود به في طريق النضوج والتكامل.
كما كانوا على جانب عظيم من الدين والورع والتقوى والمثالية والنفع، وبهذا ملكوا قلوب المؤمنين، وصاروا موضع فخرهم واعتزازهم.
ص: 322
وبذلك كله قام للحوزات كيانها المستقل، وكان لها تحركها المؤثر، وصوتها المدوي، الذي قد يُخنَق وقد ينطلق، تبعاً لاختلاف الظروف والملابسات.
وكان من الصعب بل المتعذر على القوى الفاعلة في الساحة النفوذ فيها والسيطرة عليها لحرفها عن مسارها، وصرفها عن أهدافها، وما يستتبع ذلك من اكتفائها في طلب العلم الديني وتحديد الرتب بالسطحية والشكليات الرسمية من أجل المراتب الوهمية على حساب الحقيقة، ولو بالالتفاف على الأنظمة وتطويعها بوجه غير مشروع، كما تبتلى بذلك المؤسسات الرسمية عامة، خصوصاً في الفئات المغلوبة على أمرها. وقد امتازت الحوزات الشيعية بذلك عن المؤسسات الدينية لباقي المذاهب والأديان. كما يظهر ذلك بأدنى مقارنة وملاحظة (1)
إن هذه الإيجابيات وغيرها هي التي دعت الباحث المتخصص في علم التربية ورئيس وزراء العراق الأسبق الدكتور محمد فاضل الجمالي لأن يكتب في بحث ميداني له عن جامعة النجف الدينية كان قد أجراه في شهر تشرين الثاني من عام 1957م / 1376 ه قائلا : لقد درست أغلب نظم التعليم الجامعي في الغرب، وزرت الجامعات الألمانية والبريطانية والفرنسية وجامعة أكسفورد وكامبرج، وتلقيت تعليمي في الجامعات الأمريكية، إلّا أنه ما من جامعة من هذه الجامعات حتى الجامعات الألمانية تستطيع أن تفخر في حرية التعليم بما يضاهي حرية التعليم والعمق في جامعة النجف، والتي تطبع شخصية المنتسبين اليها بطابعها المتميز. فالنظام التعليمي لا يخضع لنفوذ الدولة، ولا يموّل من قبلها وبالرغم من وجود (24) مدرسة علمية فإنه لا توجد هيئة خارجية أو سلطة تسيطر عليها أو تقوم بإدارتها، كما لا يوجد رؤساء أو عمداء أو أساتذة، وإنما يستطيع أي فرد مهما كان مستواه الثقافي أن ينضم للمدرسة إذا استطاع أن يجد له مكانا للإقامة مادامت لديه الرغبة في الدراسة، كما أن القانون الذي يدير هذه
ص: 323
الجامعات وينظمها هو فقط الوازع الديني(1).
وهناك غير هذه وتلك من الإيجابيات التي لا يسع المجال لذكرها في هذا المختصر.
ص: 324
وإذ كان لنظام الحوزة العلمية إيجابياته المعروفة فيما تقدم، ومنها وهو ما يدعو إلى التأمل والإعجاب حقا تخريج هذا العدد الضخم من المراجع والفقهاء الكبار والمجتهدين والمصلحين والمفكرين والمبلغين فإن ذلك لا يمنع من وجود سلبيات في نظامها التدريسي يحدوني الأمل بقدرة مراجعها المعاصرين في النجف الأشرف على تخطيها وإصلاح ما ينبغي إصلاحه منها بعد انتهائهم من معركتهم الحالية في إصلاح الوضع العراقي العام، وهو ما أرجو أن يشكل حافزا لإصلاح البيت الحوزوي من الداخل، ولقد شخص المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه) بعضا من هذه السلبيات في جواب منه عن سؤال وجهته إليه ذاكرا منها :
أولاً: هدر كثير من القابليات نتيجة الحرية المذكورة، وفقد النظام حيث لا يؤدي الكثير واجبهم ولا يستفرغون قدراتهم في طلب العلم أو في التدريس أو في التبليغ، كسلاً أو ضجراً من دون قوى تردعهم عن ذلك.
ثانياً : ضياع بعض المؤهلين لعدم تيسر ظهورهم على الساحة بعد فقد المعايير الدقيقة والحدية لتقييم الأشخاص، ومنها: حرمان كثير من ذوي الكفاءات من حقوقهم المادية والمعنوية التي يستحقونها بسبب كفاءاتهم لصعوبة تمييزهم عن غيرهم بعد فقد طرق التقييم الرسمية.
ص: 325
ثالثاً : فتح باب الدعاوى غير المسؤولة والتصدي لغير المؤهلين(1). وهو ما جرّ في الآونة الأخيرة إلى مآس ومصائب ومنغصات لا يعلمها حق علمها إلا من قاسوها أو تجرعوها واكتووا بنارها.
ذلك أن الحوزة العلمية التي يفترض في منتسبيها من أساتذة وطلاب السعي لنيل رضا اللّه عز وجل وحده قد لا تتمكن لظروف شتى من جعل الإخلاص والواقعية والتجرد والزهد وما إلى ذلك من الصفات الحميدة الأخرى ديدن جميع منتسبيها طلاباً وأساتذة ومدّعين، فقد بتنا نرى وجود من يستثمر هذه الحرية المتاحة في طريقة التدريس، وعدم وجود قيود على التزيي بالزي الخاص لطلاب الحوزة العلمية، ممن لا يتحلى بوازع من دين ولا رادع من خوف اللّه عز وجلّ ولا ضمير، مدعياً ما ليس فيه لغرض في نفسه أو في نفس غيره منتحلا صورة رجل الدين أو صفة ولقب مرجع التقليد، مستغلاً بذلك طيبة قلوب المؤمنين لتمرير مآربه ونواياه.
رابعاً: قلة اهتمام المنهج المتبع بمادة تعنى بتربية دواخل نفس الطالب وتزكيتها وتهذيبها وتدريبها على أساس أن رضا اللّه عز وجل هو الهدف الأسمى الذي يسعى طالب الحوزة لنيله، ومن يسعى لنيل رضاه جل وعلا تهون في عينه الدنيا وما فيها، وبخاصة وأنه في حضرة الإمام علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) إمام المتقتين وقدوة الزاهدين، وفي أجواء نه بلاغته وحكمه ومواعظه، وتحت منابر من اهتدوا بهديه واتخذوه أسوة حسنة، وربما يعزى سبب عدم وضع منهج تعليمي خاص بتزكية النفوس راجع إلى الثقة بمن اختار سلوك هذا الطريق بنفسه والاتكال عليه في تهذيب نفسه مادام هو الذي وضع نفسه هذا الموضع طواعية.
ولعل الأوضاع الحياتية اليومية للأساتذة والمجتهدين والمراجع والصالحين خير مربٍ ومهذب ومزك لمن أراد من تلاميذهم طلابهم تزكية نفسه من زخارف الدنيا الفانية
ص: 326
وتنقيتها من شوائبها وتهذيبها من التعلق بزخارفها، وليس كل الطلاب والمحسوبين على الحوزة مع الأسف يتعظون بمراجعهم الزهاد الأتقياء وبخاصة في هذه الأيام.
إنه لمن أولى الأولويات أن يجهد النظام التربوي الحوزوي نفسه ليكتشف آليات خاصة به تساعده على إدامة حالة الزهد والتقوى والرضا بما قسم اللّه عز وجل في نفوس طلاب الحوزة مع عدم الاكتفاء بتذكيرهم بذلك ودعوتهم اليه بالقول فقط، وبخاصة في هذه الأيام التي بات يلاحظ عزوف العديد منهم عن هذه الحالة التربوية المهمة، فمن دون منهج تربوي واضح المعالم محدد الأهداف يقود الطالب إلى حيث جعل كل همه هو رضا اللّه عز وجل، تبقى الخشية من نقص الإعداد في الجانب الأخلاقي مؤثرة فاعلة.
خامساً: عدم وجود شروط لقبول الطالب الجديد الذي ينوي أن يكون طالبا حوزويا يدخل غمار البحث العلمي الرصين والغوص في عباب الآراء والنظريات والمناقشات والرأي والرأي المخالف وحمل همّ التبليغ وتوصيل ما استفاده من دراسته إلى المحتاجين.
إن وضع نظام مدروس بعناية لقبول الطلاب الجدد يتضمن من بين شروط أخرى آليات لمعرفة قابليات الطالب الذهنية وجديته في الانخراط بهذا المسلك، واستعداده النفسي لمكابدة الصعاب من أجل بلوغ غايته العلمية والتربوية ومدى التزامه بأحكام و آداب وقيم وأخلاق المؤمن إضافة لدوافعه الحقيقية وماضيه وحاضره وما إلى ذلك من شؤونه الأخرى بات شبه أساسي في الحوزة العلمية النجفية بل في الحوزات العلمية كلها.
سادساً: خلو النظام الحوزوي من وجود ضوابط ومحددات لمدى تأهيل الأستاذ لتدريس علم معين يقوم هو بالفعل بتدريسه، بل ولمدى صلاحيته للتدريس أصلا،
ص: 327
ذلك أن هذا الأمر متروك لرغبة الأستاذ في أن يدرّس ما يشاء كيف يشاء متى يشاء، وقد حدث ويحدث أن لا يكون الشيخ صالحا لتدريس هذا الفن، أو لا يكون صالحا للتدريس اصلا، ويغترّ به الطلاب(1) مما يتسبب في ضرر للطالب وهدر للجهد والوقت وغيرهما مما هو واضح.
سابعاً: عدم وجود ضوابط محددة للتزيي بزي العمة الشريفة ولقد بات من النافع جدا وضع ضوابط ذات قوة حوزوية تنفيذية لها القدرة المعنوية والمادية على تطبيق قراراتها لتحدد إضافة للالتزام الدقيق بالأحكام والأخلاق الإسلامية الرفيعة المقتدية بما ورد في قوله تعالى بحق رسوله الكريم محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» المستوى العلمي والأخلاقي والسلوكي لمن يحق له التزيي بزي رجل الدين ومن لازال غير مؤهل لذلك بعد.
ثامناً : عدم التصدي الجدي لإصلاح المناهج المقررة تعيّنا في الحوزة العلمية وعدم إضافة ما بات ضروريا اليها بما يؤهل الطالب للقيام بالدور الذي سيضطلع به على أحسن وجه في قابل أيامه.
ولقد شغل موضوع تأليف كتب جديدة لتحل محل الكتب الدراسية الحالية المهتمين بالشأن الحوزوي في النجف الأشرف من المراجع فمن دونهم من الأساتذه والعلماء والباحثين الحوزويين لاستيضاحهم حقيقة مفادها أن ارتفاع المستوى العلمي في الحوزات وتطوره بمرور الزمن جدّد الحاجة إلى تبديل الكتب الدراسية والارتفاع بمستواها إلى ما يتناسب والتطور الذي حصل ليساهم الكتاب في انفتاح الطالب على المعلومات المستجدة وهضمها وتهيئته لتطويرها والارتفاع بالمستوى العلمي لنفسه وللحوزة التي هو فيها(2). وبخاصة أن الأعم الأغلب من الكتب الدراسية المعتمدة إن لم نقل كلها كتبت بأسلوب قديم والآن اختلفت أساليب التعبير والكتابة عما كان
ص: 328
عليه الحال في تلك العصور(1). وأنها لم تعدّ لتكون كتبا دراسية في المنهجية والتبويب والمادة المعروضة وأسلوب العرض وقوة البيان والتعبير، على أن كثيرا منها لا يستوعب دورة علمية تامة (2).
إضافة إلى طرحها لمسائل عفا عليها الزمن من ناحية وعدم احتوائها على ما جد من نظريات وآراء حديثة صقلتها مدرسة النجف الأصولية والفقهية عبر مخاض بحثها العميق من ناحية ثانية، وتأثر علماء الفقه و أصول الفقه بالفلسفة والمنطق تأثرا واضحا على اختلاف في درجة التأثر بين عالم وآخر من ناحية ثالثة، ويلاحظ هذا التأثر في مباحث عديدة منها في موضوع علم الأصول واشتراط وجوده ووحدته استفادوا من قاعدة السنخية بين العلة والمعلول وقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد أو الواحد لا يصدر إلا من واحد وكذلك اعتمدوا على قاعدة الواحد في لزوم وجود الجامع بين الأفراد في بحث الصحيح والأعم وفي موضوع المعنى الحرفي تعرضوا إلى موضوع الوجود وأقسامه الذي يبحث عنه في الفلسفة، وكذلك استفادوا من فكرة الجنس والفصل وفرقهما عن المادة والصورة من أخذ ال(لا بشرطية) عن الحمل في الجنس والفصل بينما أخذ ال(بشرط لا) عن الحمل في المادة والصورة.
وفي بحث الأوامر تعرضوا إلى مسألة كلامية اختلف فيها المتكلمون منذ القدم وهي مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين ومسألة كلام اللّه والإرادة والطلب وتعرضوا خلالها إلى بعض المسائل الكلامية كما يلاحظ ذلك في كفاية الأصول وفي بحث الضد اعتمدوا على فكرة استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين أو المثلين واستخدموا مصطلحات: السبب والمقتضي والشرط والمانع والعلة التامة والناقصة وفي مبحث المطلق والمقيد بحثوا عن التقابل وهل أن التقابل بين المطلق والمقيد تقابل العدم والملكة أو تقابل التضاد، وقد استفادوا في القطع من مبحث الجعل الذي يبحث عنه في
ص: 329
الفلسفة (1) وغير ذلك كثير.
وقد ذكر الباحث مجالين لهذا التأثر هما مجال الألفاظ والمصطلحات ومجال القواعد(2).
وكان سبق أن عدّ سماحة السيد محسن الأمين (قدّس سِرُّه) قبل أكثر من قرن من الزمان وجود خلل في تدريس علم الأصول وهو إدخال مسائل الكلام في علم أصول الفقه(3).
وسيأتي الحديث عن موضوع الكتب المقررة في نظام الحوزة الدراسي بشكل أوسع في الفصل القادم.
تاسعاً: عدم وجود آلية ما تدفع الطالب نحو الالتزام بالدراسة والحضور اليومي كما تقدم سوى الدافع الذاتي وحده، لذا ينبغي العمل على وضع آليات مصاحبة هدفها تقوية الدافع الذاتي للطالب وصولا به نحو الجدية في الدراسة والحضور والمتابعة والمطالعة والمباحثة الدؤوبة المنتجة.
عاشراً: عدم تحديد سقف زمني معين يتراوح بين حدين أدنى وأعلى لكل مرحلة من مراحل الدراسة الحوزوية، بل ولكل كتاب دراسي من كتبها المقررة في كل مرحلة من مراحلها الدراسية، مما يترك المجال مفتوحا أمام الطالب ليقرر الانتهاء من أية مرحلة يشاء أو كتاب يشاء، ولئن كانت مراعاة الظروف الخاصة لكل طالب مطلوبة، والحرية المتاحة في الدراسة وأوقاتها محببة، إلا أنها في أحيان كثيرة باتت تخرج عما أريد لها أن تكون لأسباب شتى غالبها شخصي تتعلق بالطالب نفسه تدفعه إلى التماهل والتسويف والتغيب غير المسموح به، وقد بان هذا التفاوت واضحا في المدد التي يقضيها بعض الطلاب في دراسة موضوع ما أو كتاب ما فالبعض يدرس علم الأصول في اثنتي عشرة سنة، والبعض الآخر في ست عشرة سنة، وثالث في ست سنوات(4).
ص: 330
حادي عشر : ليس هناك في النظام الحوزوي السائد ما يلزم الطالب أن يتم المرحلة أو الكتاب الدراسي الذي هو فيه قبل انتقاله إلى المرحلة أو الكتاب اللاحق له، بل إن الأمر متروك للطالب نفسه فمنهم من يوفق إلى تطبيقه تطبيقا تاما فلا يقرأ في كتاب حتى يتم ما قبله ويتقنه، ولا في علم حتى يفرغ من الذي قبله ويتقنه، ولا يقرأ درس الخارج حتى يفرغ من السطوح، وكثير منهم لا يطبق هذا البرنامج فيشرع في الكتاب المتأخر قبل إكمال المتقدم، وفي درس الخارج قبل إتقان السطوح، فلا يستفيد شيئا أو يستفيد فائدة قليلة في مدة طويلة(1).
ثاني عشر : عدم فتح باب التخصص الدقيق في علوم الشريعة بعد مرور الطالب الحوزوي بشكل إلزامي بسنوات الدراسة العامة المتقنة للعلوم، بحيث لا ينتهي الطالب من مرحلة بناء الأساس العلمي المستوعب إلّا وقد أحاط إحاطة تامة بكل ما ينبغي له أن يحيط به ويهضمه من علوم الشريعة والعلوم الأخرى المساعدة وفي مقدمتها علوم العربية. ثم يتخصص في فرع منها بعد ذلك.
إن فتح باب التخصص الدقيق في العلوم أثبت نجاحه على أصعدة العلوم كافة تجريبية ونظرية، وطبيعي أن يثبت نجاحه في علوم الشريعة عندنا أيضا لو تمت دراسته دراسة علمية.
كما إن فتح باب التخصص الدقيق في أبواب مثل القضاء والأديان والمذاهب والتبليغ بقسميه الداخلي والخارجي الذي يتطلب من جملة ما يتطلب دراسة المبلغ المختار للتبليغ في بلد معين للغة ولهجة و طباع وعادات وتقاليد وقيم وثقافة ومجتمع وسياسة ذلك البلد وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة عمل المبلغ حتى ينجح في مهمته بعد أن يندمج بمجتمعه الجديد اندماجا كاملا. وهو ما نفتقده كثيرا في العديد من المبلغين القادمين إلى دول ربما لا يعرفون لغتها اليومية المتداولة فضلا عن ثقافة مجتمعها فيتعثر
ص: 331
مسعاهم او يفشلوا في مهمتهم.
ثالث عشر: إلقاء مسؤولية البحث في علوم القرآن وتفاسيره، والحديث وعلمه والرجال وعلمه على الطالب، وإن بتوجيهات أساتذته، غير كاف ولا ناهض بتزويده بثقافة قرآنية وحديثية ورجالية أساسية هو أحوج ما يكون اليها بحكم تخصصه، فما دام النظام الحوزوي والمنهج الدراسي لا يلزمان الطالب بهذه العلوم، فسيبقى الطالب بحاجة إلى سدّ هذا النقص المعلوماتي الكبير، وهذه سلبية تؤشر على النظام والمنهج الحوزوي، ما يستدعي معالجة شافية تلزم الطالب بحفظ القرآن أو سور منه إضافة لآيات الأحكام مع إلمام كاف بعلم حديث المعصومين ورجال الحديث من خلال دراسة منهجية متدرجة لعلوم القرآن ومناهج تفاسيره ومفسريه المختلفة، وعلم الحديث، وعلم الرجال ومناه- وكتب المحدثين والرجال وصولا إلى البحث الخارج فيها.
رابع عشر : خلو المنهج الدراسي المتبع في حوزة النجف الأشرف من مادة أو مواد تعنى بالدراسات الأصولية والفقهية المقارنة بين المذهب الجعفري والمذاهب الإسلامية الأخرى، وهي مادة باتت حاجة الفكر الإسلامي والحوزات العلمية اليوم أكثر أهمية عما كانت عليه تلك الأهمية في العقود والقرون الماضية، ورغم أن سماحة السيد محمد تقي الحكيم تل قد أدرك قبل أكثر من نصف قرن أهمية الدراسات الأصولية المقارنة فكتب لذلك كتابه الرائد في بابه (الأصول العامة للفقه المقارن)، سالكاً في تأليفه منهجا جديدا في حصر المسائل الأصولية وتبويبها وساعيا إلى تأسيس أصول للمقارنة الفقهية بين المذاهب الإسلامية المختلفة، محاولا ضبط وتطوير أصول للفقه المقارن فيه سعة و شمول نسبيان لمختلف المدارس العلمية وفي مقدمتها مدرسة النجف الأشرف الحديثة هادفا من خلال مشروعه التأسيسي إلى:
ص: 332
1 - محاولة البلوغ إلى واقع الفقه الإسلامي من أيسر طرقه واسلمها، وهي لا تتضح عادة إلّا بعد عرض مختلف وجهات النظر فيها وتقييمها على أساس موضوعي.
2 - العمل على تطوير الدراسات الفقهية والأصولية والاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف.
3- إشاعة الروح الرياضية بين الباحثين ومحاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية وإبعادها عن مجالات البحث العلمي.
4 - تقريب شقة الخلاف بين المسلمين والحد من تأثير العوامل المفرقة التي كان من أهمها وأقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس وركائز البعض الآخر مما ترك المجال مفتوحا أمام تسرب الدعوات المغرضة في تشويه مفاهيم بعضهم والتقول عليهم بما لا يؤمنون به(1). حتى قيل : إن هذه المبادرة لا تكمن قيمتها في كونها لم تسبق بنظير فحسب، بل لأنها تعد بحق مشروعا تاسيسيا جادا يهدف إلى التقريب بصورة فعلية وعملية وليس على نحو الوعظ والدعوة الحماسية المجردة، فالدعوة إلى التقريب يجب أن تخرج عن حالة الوعظ إلى حالة جادة بوضع برنامج عملي والقيام بخطوات فعلية تاسيسية في هذا الإطار وخاصة في حقل الأصول والمباني الفقهية(2). وأنه وفق لعله للمرة الأولى لنقل شطر جيد من خبرة وجدة وأصالة وعمق مدرسة النجف الأشرف في الأصول إلى أوساط الاختصاص الفقهي في العالم العربي، ولأول مرة يطلع فقهاء المسلمين على آفاق جديدة لهذا العلم... عبر هذا الكتاب الجليل.
ورغم أن المؤلف العلامة حافظ بأمانة على عمق أفكار هذه المدرسة فيما عكس من أفكارها في هذا الكتاب، إلّا أنه استطاع في نفس الوقت أن أن يذلل لغة الاختصاص وييسرها لأصحاب الاختصاص من غير هذه المدرسة، وهو عمل شاق وعسير يعرف
ص: 333
قيمته جيدا من مارس تجربة من هذا القبيل في هذا الاختصاص العلمي(1).
كما كتب ودرّس مؤلف كتاب (الأصول العامة للفقه المقارن) موضوع (القواعد العامة في الفقه المقارن) مقارنا فيه بين قواعد الفقه في المذهب الجعفري وقواعد الفقه في المذاهب الفقهية الأخرى المختلفة من خلال منهجة جديدة، مستكملا بذلك نهجه في الدراسات الإسلامية المقارنة وقد طبع بعض هذه الأبحاث في كتاب مختصر أسماه (القواعد العامة في الفقه المقارن).
إلّا أن المنهج الدراسي السائد اليوم لا زال لليوم لم يول مبدأ المقارنة بين أصول وفقه المذهب الجعفري و أصول وفقه بقية المذاهب الإسلامية الأخرى أهميته الكبيرة، وأخال أن هذا من جملة الأسباب التي أبقت كتاب: (الأصول العامة للفقه المقارن) وكتاب (القواعد العامة في الفقه المقارن) يتيمين لم يردفا بمثيل، ليس في الحوزة العلمية النجفية فحسب بل في الحوزات العلمية الأخرى أيضا.
هذا وهناك من السلبيات الأخرى التي هي أقل أهمية مما تقدم لا يسع المجال لذكرها في هذا المختصر.
ص: 334
(1) من دراسة للمرجع الشيخ الفياض عن أستاذه السيد الخوئي. مجلة النور:العدد 176. أيلول 2006م
(2) من مقدمة كتاب النص والاجتهاد. سابق : 55
(3) الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. الشيخ محمد مهدي الأصفي : 26.
(4) ينظر: لمحات من حياة الشيخ الأنصاري. الشيخ محمود سبط الشيخ. مجلة الفكر الإسلامي. العدد السابع السنة الثانية. عدد خاص بالشيخ الأنصاري. رمضان 1415ه ص : 16 - 18. ونظر أيضا الخصائص العلمية والأخلاقية للشيخ الأعظم الأنصاري. السيد محمد علي الموسوي الجزائري. تعريب عباس الأسدي. المجلة نفسها والعدد نفسه. ص : 146-148 وغير هذين كثير.
(5) : النجف الأشرف مهد الفضيلة والعلم. سابق : 73.
(6) النجف الأشرف مهد الفضيلة والعلم. سابق : 73.
(7) هكذا عرفتهم. جعفر الخليلي: 1/ 114 - 115.
(8) : النجف الأشرف مهد الفضيلة والعلم. سابق : 73.
(9) موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية. الشهيد السيد محمد باقر الحكيم : 3/ : 51.
(10) المصدر السابق : 3/ : 55-56.
(11) السابق : 3/ : 145.
ص: 335
(12) المصدر نفسه 3/ هامش ص 144.
(13) الفكر الإمامي من النص إلى المرجعية 306 307.
(14) أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف. سابق : 350.
(15) المصدر السابق : 348.
(16) موسوعة النجف الأشرف جامعة النجف الدينية : 6 / 231 نقلا عن جامعة النجف للشيخ محمد تقي الفقيه.
(17) الديوان. د. السيد مصطفى جمال الدين: 14
(18) الديوان. د. السيد مصطفى جمال الدين: 14 - 16
(19) موسوعة النجف الأشرف : 6 / 96 نقلا عن مبحث نشوء الحوزة العلمية من كتاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف. لعلي البهادلي.
(20) المصدر السابق نقلا عن النجف الحضارية لنصر اللّه بحث منشور في مجلة الغدير. بيروت لبنان. العدد 2 لسنة 1981م.
(21) المصدر السابق : 6 / 96 نقلا عن مبحث نشوء الحوزة العلمية من كتاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف.لعلي
(22) هكذا عرفتهم. سابق: 1 / 248.
(23) مرجعية التقليد. سابق : 132
(24) المصدر السابق : 14 - 15
(25) الشيخ الأنصاري من خلال آراء الفقهاء والعظماء والمؤلفين. محمد جواد الطبسي: 8 -9.
(26) لمحات من حياة الشيخ الأنصاري. سابق. 20.
(27) فقيه وأخلاقي كبير تولى بعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري مواصلة بحث
ص: 336
الشيخ الأنصاري من على كرسي الشيخ نفسه متما بحث شيخه الفقهي من حيث انتهى، بيد أنه لم يعمر طويلا فقد توفي بعد وفاة الشيخ الأنصاري بستة أشهر، ولعل من أشهر تلامذة السيد التستري الحكيم العارف المولى حسين قلي الهمداني، وقد نقل العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان قصة يستفاد منها أن الألطاف الغيبية تدخلت في نقل السيد التستري نحو العرفان والسير والسلوك (ينظر خصائص المدرسة السلوكية. سابق : 194 نقلا عن رسالة لب اللباب : 156 ).
(28) مجلة حوزة الإيرانية، العدد الأول : 53 نقلا عن من خصائص المدرسة السلوكية للفقيه الهمداني بحث عرفان محمود مجلة الفكر الإسلامي العدد الثامن السنة الثانية 1415 ه- : 194.
(29) رحلتي الدراسية مع السيد التقي الحكيم. الدكتور محمود المظفر. منشور ضمن: كتاب السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف : 349.
(30) المصدر السابق. الصفحة نفسها.
(31) من مقدمة كتاب النص والاجتهاد. سابق : 56، وينظر : الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. الشيخ محمد مهدي الآصفي: 16.
(32) الشاعر محمد جواد الغبان يروي سيرته بعد أن غبن النظام السابق حقوقه. حوار: علي دنيف حسن. جريدة الصباح العراقية في: 27 / 10 / 2006 م.
(33) مقدمات كتب تراثية. السيد محمد مهدي الخرسان : 2/ 486.
(34) المرجعية الدينية / 2 في حوار صريح مع المرجع السيد محمد سعيد الحكيم. عبد الهادي الحكيم : 44.
(35) جامعة النجف الدينية. د. فاضل الجمالي. بحث. مجلة شؤون إسلامية العدد الثاني.
ص: 337
السنة الثانية 1420 ه- ص 13. وكذلك مجلة الموسم. العدد: 119/18.
(36) المرجعية الدينية / 2. سابق.
(37) موسوعة النجف الأشرف جامعة النجف الدينية : 6 / 189 نقلا عن: أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين المجلد العاشر. سيرة المؤلف.
(38) علم الأصول نظرة جديدة في مناهجه الدراسية في حوزة النجف. حوار مع المرجع السيد محمد سعيد الحكيم. مجلة التحقيق والحوزة. سابق : 109.
(39) حوار مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني. مجلة فقه آل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ). العدد 35 من السنة التاسعة. 2004م. ص 178.
(40) علم الأصول نظرة جديدة في مناهجه الدراسية في حوزة النجف. سابق : 109، وينظر : المصدر السابق: 179
(41) مدى تأثر علماء الفقه والأصول بالفلسفة.1. السيد هاشم الهاشمي بحث مجلة رسالة الثقلين. المجمع العالمي لأهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ). العدد التاسع من السنة الثالثة. 1415 ه/ 1994 م ص : 180-182.
(42) ينظر على التوالي : المصدر السابق 83، والعدد العاشر من المجلة نفسها للسنة نفسها : 134
(43) موسوعة النجف الأشرف جامعة النجف الدينية : 6 / 189 سابق : نقلا عن : أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين المجلد العاشر. سيرة المؤلف.
(44) حوار مع المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي مجلة فقه أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ). العدد 35 من السنة التاسعة 2004م ص: 173.
(45) موسوعة النجف الأشرف. جامعة النجف الدينية سابق : 6 / 188 نقلا عن أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين المجلد العاشر. سيرة المؤلف وقد كتبها
ص: 338
قبل أكثر من قرن من اليوم.
(46) الأصول العامة للفقه المقارن سابق : 10.
(47) أسس الدراسة الأصولية المقارنة عند العلامة الحكيم. د. عبد الجبار شرارة. بحث منشور ضمن كتاب السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف: 291. وينظر آية اللّه الحكيم قدوة فكرية في مجال التقريب الشيخ محمد علي التسخيري بحث منشور ضمن الكتاب نفسه: 278.
(48) المنهج العلمي لكتاب الأصول العامة للفقه المقارن للسيد الحكيم. بحث. الشيخ محمد مهدي الآصفي. منشور ضمن بحوث كتاب: السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف: 130.
ص: 339
ص: 340
ويتناول هذا الفصل المبحثين التاليين:
المبحث الأول : بعض من محاولات إصلاح المنهج الدراسي المتبع في مرحلة المقدمات. ويتضمن مطلبين :
المطلب الأول : تأليف كتب دراسية جديدة لتحل محل الكتب الدراسية القديمة.
المطلب الثاني : إجراء تعديل على المنهج الدراسي المتبع في مرحلة المقدمات.
المبحث الثاني : بعض من محاولات إصلاح المنهج الدراسي المتبع في مرحلة السطوح. ويتضمن مطلبين :
المطلب الأول: تأليف كتب دراسية جديدة لتحل محل الكتب الدراسية القديمة في علم الفقه.
المطلب الثاني : تأليف كتب دراسية جديدة لتحل محل الكتب الدراسية القديمة في علم الأصول.
ص: 341
ص: 342
لعل من أولى الإشكاليات على نظام الحوزة العلمية وأقدمها هي مشكلة تحديث المنهج التدريسي المتبع تعينا في الحوزة العلمية النجفية وفي الحوزات الدينية بعامة، فهذه الإشكالات ليست بجديدة ولا هي وليدة هذا العقد من الزمن، بل تم من الزمن، بل تم تشخيصها منذ الثلث الأول من القرن العشرين وربما قبله، ولقد تشكلت جمعية منتدى النشر وأجيزت رسميا سنة 1935 م / 1353م لتجعل من أولى مهامها إصلاح المنهج التدريسي المتبع في مرحلتي المقدمات والسطوح.
أما محاولات إصلاح المنهج المتبع في هذه المرحلة فقد تنوعت بين تأليف كتب دراسية منهجية جديدة لتحل محل الكتب المتبعة، أم بتعديل ما على المنهج المتبع لدراسة علم ما من علوم هذه المرحلة، أم بإضافة علوم جديدة لمنهج الطالب الدراسي يقتضيها الوضع الحاضر وسأعرض ذلك في مطلبين:
سعى بعض المصلحين بدأب وجرأة إلى تأليف كتب منهجية جديدة لتحل محل الكتب الدراسية القديمة في مرحلة المقدمات بعد أن شخصوا الحاجة الماسة لذلك، فقد ألف سماحة الشيخ محمد رضا المظفر كتابه الرائد في علم المنطق ووسمه باسم
ص: 343
(المنطق) ليحل محل كتابي (الحاشية) و (شرح الشمسية) وقد سادت دراسته بشكل كبير إما بالاكتفاء به لوحده في هذا العلم وهو الغالب أو بإضافة كتاب الحاشية أو شرح الشمسية إليه وهو قليل أو كليهما وهو نادر.
ومن الحق أن يقال إن سماحة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر (قدّس سِرُّه) قد قدم خدمة جليلة لدارسي علم المنطق ممن هم في مرحلة المقدمات بتأليفه كتابه المنهجي (المنطق) ثم لدارسي علم أصول الفقه ممن هم في مرحلة السطوح بتأليفه كتابه في )أصول الفقه) فهذان الكتابان يعتبران فتحا كبيرا في هذا الباب، ولا يجد الباحث عسرا كثيرا ليلتمس الجهد الكبير الذي بذله الشيخ الفقيد لتبسيط المنطق والأصول في هذين الكتابين مع صعوبة المادة في ذاتها. ولا يقتصر الجهد التجديدي الذي بذله الشيخ المظفر في هذين الكتابين على تبسيط العرض ففي هذين الكتابين وجوه أخرى من التجديد والتطوير لا توجد في الكتب الأخرى.
وقد حاول المؤلف أن يجاري في هذين الكتابين أحدث التأليفية في كتب الدراسة الجامعية من العرض والتبسيط والتمثيل والتمرين والتنسيق والتعليق وحبذا لو قام أعلام الفكر من أمثال الفقيد بالاشراف على تأليف الكتب الدراسية من جديد وفق المناهج الحديثة(1).
فمن الجدة في تأليفه لكتاب المنطق مثلا اتباعة خطة لبحث الموضوعات المنطقية ومنهجتها أخذ فيها واضعها قدرتها على أن تسلسل الموضوعات تسلسلا هو الآخر (منطقيا) كموضوع الكتاب نفسه، فالموضوع الثاني يبتني على سابقه بحيث لا يمكن للقاريء أو الدارس المبتديء فهم الموضوع اللاحق إلا بالمرور عبر سابقه قراءة متعمقة أو دراسة متأنية، فالموضوعات تتسلسل تسلسلا (منطقيا) بحيث تسلم واحدتها للأخرى بسلاسة أسلوبية تتعاضد مع سلاسته المنطقية والمنهجية لتشبع نهم القاريء
ص: 344
المعرفي من غير حاجة إلى إحالته إلى مصدر آخر كي يستوضح المعنى المنطقي المقصود بالبحث ولا الطلب اليه بأن يراجع موضوعا لاحقا سيأتي بحثه فيما بعد كي يستوضح سابقه وهكذا.
ومن مظاهر هذه الجدة أيضا توظيفه (لعلامات يستعملها علم الرياضيات للنسب الأربعة عند المناطقة) أوعند بحثه لموضوع (القسمة).إضافة إلى وضعه أسئلة بعد نهاية كل مبحث في الكتاب هدفها استكشاف مدى إحاطة الطالب بمبحثه الذي درسه من خلال آلية محددة لاختبار معلومات القارئ أو الطالب لاستكشاف مدى ما استوعبه الطالب من مبحثه الذي أتمّه وختمه وهي طريقة لم تعتد عليها كتب الدراسة الحوزوية من قبل، كما أن طريقة وضعه (قدّس سِرُّه) لها تنبيء عن فهم دقيق لكيفية وضع أسئلة قادرة على تحديد مدى استيعاب الدارس لدرسة، وهي قدرة لا يمتلكها إلّا دارس أصول علم التربية وطرائق وضع الأسئلة الكاشفة عن المستوى المطلوب اكتشافه. وغير هذا وذاك من جدة الكتابة والتأليف كثير.
أما فيما يتعلق بالمطلب الثاني الخاص بإجراء تعديل على المنهج المتبع في مرحلة المقدمات فقد شمل ذلك عدة مواد منها، ففي مادة علم الفقه وحرصا من أساتذة الحوزة العلمية على اجتياز الطالب دورة أساسية أولية بعلم الفقه، وحثاً له على الإحاطة بفتاوى المرجع الأعلى أو المرجع المقلَد، إما لعمل الطالب نفسه بها إذا كان مقلدا للمرجع صاحب الرسالة العملية أو للإجابة عن أسئلة السائلين من المقلدين لذلك المرجع فقد درج طلاب المقدمات بحث من أساتذتهم على دراسة رسالة عملية أولا، ولعل من أشهر هذه الرسائل العملية التي ساد تدريسها مؤخرا كتاب (المسائل المنتخبة) للمرجع الأعلى في حينه سماحة السيد الخوئي (قدّس سِرُّه)، ثم دراسة كتاب (منهاج الصالحين) بجزئيه
ص: 345
له، أيضا، أو (المسائل المنتخبة ) لسماحة المرجع الأعلى اليوم السيد السيستاني (دام ظلّه)، ثم (منهاج الصالحين) بأجزائه الثلاثة له ايضا، أو كتاب (منهاج الصالحين) بأجزائه الثلاثة أيضا لسماحة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه)، وأشباه هذه من الرسائل العملية الأخرى، وغير قليل من يبدأ دراسته للفقه في هذه المرحلة بدراسة كتاب (منهاج الصالحين) ابتداء دون المرور بكتاب (المسائل المنتخبة) المختصر، ثم بعد انتهاء الطالب من دراسة هذه الدورة الأولية الأساسية لأبواب الفقه وفروعه ومسائله من خلال إلمامه إلماما تفصيليا مستوعبا لرسالة عملية معاصرة بمسائلها المستجدة، ربما يثني طالب المقدمات بدراسة كتاب: (المختصر النافع في فقه الإمامية) للمحقق الشيخ جعفر الحليّ أو ينتقل مباشرة من الرسالة العملية إلى كتاب (شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام) بأجزائه الأربعة للمحقق الحلي نفسه وهو ما بدأ يسود اليوم.
وفي مادة علم النحو فقد بدأ العديد من طلاب هذه المرحلة بعد إتمامهم لدراسة کتاب (قطر الندى وبل الصدى) وبحث من أساتذتهم على دراسة (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) لتحل محل دراسة (شرح ابن الناظم على ألفية أبيه) لأن البديل أكثر فائدة عملية لطالب النحو وأقل تعليلا نحويا وتجريدا فكريا.
ولقد كان سائدا قبل عصرنا الحاضر أن يدرس طالب النحو بعد إتمامه دراسة كتاب (المغني) وخوض عبابه كتاب (شرح الشيخ الرضي على الكافية) مختتما به دراسة النحو المعمقة، إلّا أن دراسة هذا الكتاب الذي أنتهى نجم الأئمة من تأليفه جوار الحضرة العلوية المطهرة في النجف الأشرف وأهداه لمكتبتها العلوية، بدأت تنحسر شيئا فشيئا، لأن الطالب بدأ يعتبر دراسته له وهو الكتاب العميق في النحو وفلسفة اللغة العربية زيادة على حاجته العلمية كونه لا يبغي من دراسته للنحو التخصص الدقيق فيه، بل إن دراسته لا تعدو أن تكون مقدمة لدراسة الفقه و أصوله المستلزم لفهم واستبيان
ص: 346
واستظهار واستنطاق النص الشرعى قرآنا كريما وحديثا شريفا وكتبا فقهية للأقدمين مع كل ما يمت إلى استنباط الحكم الشرعي منها أو يعين عليه بصلة من تفاسير لمحكم الكتاب الكريم والحديث الشريف إلى كتب الفقه و أصوله إلى متون الكتب التراثية بعامة، ولعلهم أصابوا في حذف الزائد من مواد الدراسة، وإن كانت نافعة، بل وأحسنوا التخطيط التربوي لمواد دراستهم التخصصية ومقدماتها.
أما في مادة (علم البلاغة) فقد بدأت تسود تدريجيا دراسة كتاب:(البلاغة الواضحة) أو كتاب: (جواهر البلاغة) لأحمد بن إبراهيم الهاشمي أو كليهما أولا، ثم كتاب (مختصر المعاني) المسعود بن عمر بن عبد اللّه التنفتازاني، ويكتفون عنده من علم البلاغة بذلك، أما ما قبل هذه المرحلة فقد كانوا يدرسون كتاب (المطوّل) خائضين عبابه المتلاطم مستنزفين الكثير من الوقت والجهد فيه حتى قال قائلهم في مقال منشور عام 1913 م/ 1331 ه ما نصه: المطول عبارته أشكل من معناه، وفيه من النحو وفلسفته، والمنطق وأدلته، وغيرها من العلوم، أكثر مما فيه من علمي المعاني والبيان، ويعزى السر في هذا التحول إضافة لما تقدم إلى شعورهم محقين بزيادته عن حاجتهم التخصصية.
وفي مواد الفلسفة والعلوم العقلية بدأ بعض الأساتذة يرجح للطلاب دراسة كتابي (بداية الحكمة ونهاية الحكمة) للعلامة الطباطبائي بعد الانتهاء من دراسة الكتب التي كان المنهج المقرر يقتصر عليها سابقا، سواء درسها الطالب في هذه المرحلة الدراسية أو في مرحلة السطوح نتيجة عمق مطالب هذين الكتابين ودقتها، وبخاصة كتاب (نهاية الحكمة) مما يصعب استيعابه على طلاب هذه المرحلة.
وفيما يتعلق باضافة كتب جديدة أو علوم جديدة محبذة تستهوي الطالب حينا، أو تستهوي أستاذه الموجِّه له في مسيرته الدراسية أحيانا، فقد يقرأ الطالب أو يعكف على دراسة كتب محددة في علوم نافعة له من أمثال علوم التفسير، والحديث، والرجال،
ص: 347
والتاريخ والسير، وفنون الأدب العربي وتاريخه، ودواوين الشعر، إضافة لقراءة كتب ثقافية عامة ينتقيها الأستاذ لطلابه ويحثهم على مطالعتها والاستفادة منها مع قراءات كثيرة مطلوبة من طالب المقدمات عادة.
ص: 348
تعددت محاولات إصلاح المنهج التعليمي المتبع في مرحلة السطوح أسوة بما حصل من محاولات إصلاح المنهج التعليمي المتبع في مرحلة المقدمات، ونظرا لأهمية هذه المرحلة الدراسية من عمر الطالب التخصصي كونها المرحلة التي تعتمد على الاستدلال وعرض الآراء المختلفة في المسائل محل البحث مسألة مسألة ومناقشتها والانتهاء من المناقشة إلى رأي مختار يستدل الباحث عليه بما وهبه اللّه من ملكة البرهان والبيان وقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، فقد ركز دعاة إصلاح المنهج التدريسي على مواد هذه المرحلة الدراسية المهمة وأولوها الوقت الكافي من البحث والتحري والاستقصاء وهو ما يقتضيني أن أفرد لها مساحة أكبر من سابقتها في هذا المختصر.
ولقد تركزت محاولات إصلاح المناهج في هذه المرحلة كما تركزت في سابقتها أيضا على شقين أساسيين، حاول المطلب الأول منها إصلاح المنهج التعليمي المتبع فيها من خلال تأليف
كتب جديدة لتحل محل الكتب القديمة المعتمدة، فيما حاول الشق الثاني إضافة
ص: 349
علوم جديدة إلى المنهج المتبع في هذه المرحلة.
لقد ركز دعاة إصلاح المنهج التدريسي في هذه المرحلة من خلال تأليف كتب جديدة لتحل محل الكتب القديمة على أهم مادتين أساسيتين من مواد هذه المرحلة الدراسية، وهما مادتا علم (أصول الفقه) وعلم (الفقه) لتحل محل الكتب القديمة
المعتمدة.
لاحظ المعنيون بإصلاح المناهج الدراسية بمادة التخصص الرئيسية الأولى علم الفقه نفسه أول ما لاحظوا أن تاريخ أول كتاب فقهي يبدأ طالب الحوزة في دراسته إلى ما يزيد على السبعة قرون، حيث عاش الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي في الفترة ما بين (602 - 676 ه) (1206 - 127م) مؤلف كتاب شرائع الإسلام الذي هو أول كتاب فقهي يدرسه الطالب ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب اللمعة الدمشقية الذي هو من مصنفات القرن الثامن الهجري حيث عاش الشهيد الأول مؤلف هذا الكتاب في الفترة ما بين (734 - 786) (1334 - 1384م)، فيما عاش الشهيد الثاني صاحب الشرح على اللمعة في الفترة ما بين (911-965 ه) ( 1505 - 1558م). أما الكتاب الثالث والأخير الذي يدرسه الطالب في السطوح وهو كتاب المكاسب فقد عاش مؤلفه الشيخ مرتضى الأنصاري في الفترة ما بين (1214 -1281 ه) (1799 - 1864م).
وبذلك يكون قد مضى على تدوين الكتاب الأول في منهج الحوزة أكثر من سبعمائة عام، بينما مضى على أحدث كتاب يدرسه الطالب وهو كتاب المكاسب أكثر من مائة
ص: 350
وثلاثون عاما. ومما لا شك فيه أن المؤلف محكوم بمشكلات عصره والتحديات الزمنية التي تواجه المجتمع الذي يعيش فيه وكذا يمثل ما يضيفه ذلك الاطار الحياتي الذي ينتمي اليه إذ ليس بالإمكان أن يتجاوز الإنسان مشكلاته الحاضرة ويتأمل في معالجة مشكلات أخرى يفترض تجددها في العصور اللاحقة(1) كمشكلاتنا نحن اليوم.
كما لاحظوا أن مسائل كثيرة في علم الفقه استجدت وهي غير مبحوثة في المنهج الدراسي السائد اليوم، في حين عالج المنهج المقرر مسائل عفا عليها الزمن لم تعد محلا لسؤال سائل ولا مشكلة ابتلائية لمستشكل ومع ذلك أولاها المنهج المقرر مساحة واسعة من عمر الطالب وجهده وطاقته، والأمثلة على ذلك معروفة وشواهدها بيّنة.
ولاحظوا أن حركة الاجتهاد الشيعي تاريخيا اتجهت نحو المجال الفردي ذاك المجال المتصل بسلوك الفرد المسلم وتصرفاته لا سلوك الجماعة الإسلامية وهو ما قال به سماحة السيد الشهيد محمد باقر الصدر والعديد من تلامذته ذاهبا (قدّس سِرُّه) إلى أن المجتهد خلال عملية الاستنباط يتمثل في ذهنه صورة الفرد المسلم الذي يريد أن يطبق النظرية الإسلامية للحياة على سلوكه ولا يتمثل صورة المجتمع الذي يحاول أن ينشيء حياته وعلاقاته على اساس الإسلام، وهذا التخصيص والانكماش في الهدف له ظروفه الموضوعية وملابساته التاريخية، فإن حركة الاجتهاد عند الإمامية قاست منذ ولدت تقريبا عز لا سياسيا عن المجالات الاجتماعية للفقه الإسلامي، إن الانكماش في الهدف وأخذ المجال الفردي للتطبيق بعين الاعتبار فقط نجم عنه انكماش الفقه من الناحية الموضوعية، فقد أخذ الاجتهاد يركز باستمرار على الجوانب الفقهية الأكثر اتصالا بالمجال التطبيقي الفردي، وأهملت المواضيع التي تمهد للمجال التطبيقي الاجتماعي نتيجة لانكماش هدفه وانكماش ذهن الفقيه عند الاستنباط غالبا إلى الفرد المسلم وحاجته إلى التوجيه بدلا عن الجماعة المسلمة وحاجتها إلى تنظيم حياتها الاجتماعية، وقد كان من
ص: 351
نتائج ترسح النظرة الفردية قيام اتجاه عام في الذهنية الفقهية يحاول دائما حل مشكلة الفرد المسلم عن طريق تبرير الواقع وتطبيق الشريعة عليه بشكل من الاشكال(1).
بل ذهب (قدّس سِرُّه) إلى أكثر من ذلك حين قال لقد امتد أثر الانكماش وترسخ النظرة الفردية للشريعة إلى طريقة فهم النص الشرعى أيضا، فمن ناحیة أهملت في فهم النصوص شخصية النبي والإمام الحاكم ورئيس الدولة، ومن ناحية أخرى لم تعالج النصوص بروح التطبيق على الواقع واتحاذ قاعدة منه ولهذا سوّغ الكثير لأنفسهم أن يجزئوا الموضوع الواحد ويلتزموا بأحكام مختلفة له(2).
وبموجب هذا الطرح فإن المناهج الدراسية بحاجة إلى إعادة النظر فيها بما يتلائم مع هذه الرؤية.
ولاحظ المعنيون بالاصلاح أيضا أن الطالب ينهي مرحلة السطوح ولا يشعر في نفسه اجتياز نصف الشوط أو ربعه إلى مرحلة الاجتهاد، والسبب واضح لأن ما يدرسه من كتب لم يشيد لزرع روح الاجتهاد في نفس الطالب فهو يبقى مهما كررها وأمثالها سنوات بعيدا عن المقصود الأساسي، بل إن تلك الكتب لم يوضع الحجر الأساس فيها لتكون محورا للدراسة وتبقى ألفاظها المطلسمة عائقا عن تلقي الفكرة بوضوح(3). وهو ما اشتكى منه كثيرا طلاب هذه المرحلة الدراسية. يقول سماحة السيد محمد كلانتر أحد شراح كتاب اللمعة ومدرسيه لفترة زمنية طويلة : إن في هذا الكتاب الجليل رغم جلالة شأنه، وعلو قدره بعض العبارات المغلقة التي لا يتسنى فهمها بسهولة لكثير من الطلاب في مراحلهم الدراسية الأولى، دون بسط في الشرح، ومهارة في التوضيح. لذا كنت ولا أزال عند ما أمر خلال ساعات التدريس بهذا النوع من العبارات الغامضة يحز في نفسي ما يلاقيه بعض الطلبة من جراء ذلك الغموض(4).
ص: 352
بید أن ذلك لا يدعونا إلى إغفال الأهمية الكبيرة لكتاب اللمعة كونه ينمي ملكة تطبيق الكبرى على الواقع الخارجي.
إلى جانب ذلك يدخل طالب الحوزة مرحلة السطوح ويخرج ولا يجد أمامه ما يمثِّل ذلك القسم الهائل من الروايات الذي يواجهه في مرحلة الخارج، فهو لا يعرف صورة واضحة عنها ولا يعرف كيف علاج حالة التعارض بالرغم من أن المجتهد لا يكون مجتهدا إلا بذلك. وهو لا يعرف لاستصحاب العدم الأزلي وكيفية تطبيقه رسما ولا أثرا، بل الأصول العملية بشكل عام لا يعرف كيفية تطبيقها(1).
وفي مقدمته لكتابه الذي أسماه (دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري) يحاول الشيخ الإيرواني أن يفصّل مقصوده أكثر ودواعيه لتأليف كتاب دراسي جديد في علم الفقه يحل محل بعض الكتب الدراسية المعتمدة في هذه المرحلة فيعمد لأن يضرب مثلا من معاناته هو خلال فترة دراسته لعلم الفقه في مرحلة السطوح هذه فيقول : لم أقرأ خلال دراستي للسطوح أحاديث أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)، لا في الصوم ولا في الصلاة ولا في الطهارة فضلاً عن الديات والحدود والتعزيرات، كما ولم أقرأ طرق الاستدلال التي يستعين بها الفقيه في مقام الاستنباط وكنت أسمع أن الروضة البهية دورة استدلالية تُعلّم الفقه من خلال الاستدلال وكنت اتقبل هذا عن تعبُّد حتى إذا ما فتحت عيني الآن قليلاً وجدت الأمر على خلاف الواقع. ان الروضة البهية تعلّمنا كيف نتلفظ بالفاظ معقدة وكيف نحل الرموز والطلاسم.
بقيت احلّ الطلاسم فترة وغاب عني ما في داخل تلك الطلاسم. بقيت أتعلم ان هذا ليس بشرط للأصل وذاك واجب للرواية انني تعرفت على هذا المقدار لا أكثر ولم أعرف الروايات الواردة في المسألة كي لا تكون غريبة عليَّ عندما اسمعها الآن لم اسمع كيف هي متعارضة ؟ وكيف نحل التعارض ؟ وإلى ماذا نرجع عند استحكام التعارض؟
ص: 353
ان هذا لم اواجهه في الروضة أجل واجهت شيئاً منه في المكاسب إلّا أن حدود كتاب المكاسب ضيقة ويقتصر على البيع والخيارات، فأين الصلاة وأين الصوم وأين الحج وأين الخمس وأين وأين وأين؟..
إننا نحتاج في مرحلة السطوح إلى كتاب فقهي يشتمل على الأقل على غالب الأبواب الفقهية نستمع فيه إلى روايات أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وكيف نعمل عند التعارض وما هي طرق الاستدلال الحديثة المتبعة عند علمائنا الأعلام مع الاشارة الموجزة إلى بعض القضايا الرجالية ولا نحتاج بعد هذا إلى العبائر ذات الطلاسم والرموز. وهل في مطالبنا العلمية وطرق استدلالنا قصور لنحتاج إلى تكميله بذلك. إنني أقول عن تجربة: لم أعرف روايات أهل البيت (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مختلف الأبواب الفقهية إلّا من خلال حضوري بحث الخارج وواجهت آنذاك طفرة جديدة وللمرة الثانية اننا بحاجة ماسة إلى تأليف كتاب يشتمل على دورة فقهية كاملة أو شبه كاملة تضم بين دفتيها مجموعة كبيرة من روايات أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) ومجموعة كبيرة من طرق الاستدلال الحديثة يكتمل افقها عند الانتقال إلى مرحلة الخارج(1).
وخلاصة الأمر أن الطالب حتى بعد اجتيازه لمرحلة السطوح : لا يعرف ربط ما قرأه في علم الأصول بما يحتاج الي استنباطه من أحكام في الفقه. ويبقى التلاقح بين الفقه والأصول خفيًا عليه إلى أن يجتاز فترة طويلة في بحوث الخارج(2).
وتأسيسا على هذه الرؤية عمد سماحة الشيخ باقر الإيرواني إلى تأليف كتابه (دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري) ليحل محل كتاب (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) للشهيد الثاني، واضعا نصب عينيه في منهجة كتابه التأكيد على أمور عدة أهمها :
ص: 354
1- عرض مقدار غير قليل من الروايات في كل مسألة ليكون الطالب على أهبة الاستعداد لمواجهة ذلك الكم العظيم من الروايات في مرحلة الخارج.
2- عرض الروايات المتعارضة وتوضيح طرق علاجها.
3- تأكيد ربط أحكام الفقه بقواعد الأصول لتتضح بذلك فائدة علم الأصول ومقدار الحاجة اليه.
4- الإشارة إلى بعض النكات الرجالية ليستعد الطالب لمواجهة التفاصيل في مرحلة الخارج وليتفاعل معها في وقت أقرب.
5- حاول الكتاب أن لا يجود بالألفاظ، ولا يشح بها، ويضغط بعض الأفكار العميقة في عبارة صغيرة حفاظا على العلاقة بين التلميذ وأساتذه.
6- عملية عرض الأحكام الفقهية والاستدلال عليها لم تتم إلّا في بعض قليل مما أشار اليه فقهاؤنا الأبرار لأن مقصودنا تدريب الطالب على عملية الاجتهاد وتقديم رأس الخيط له. وذلك لا يتوقف على استعراض جميع الأحكام والاستدلال عليها، بل ان ذلك التوسع يوجب التشويش على الطالب وعدم الوصول إلى المقصود.
7- طريقة الاستدلال لم تقم على أساس رأي فقيه معين بل نلاحظ ما هو الأنسب لتدريب الطالب(1).
ثم ان سماحة الشيخ الإيرواني شرع بتأليف كتب فقهية متعددة لتحل محل كتاب (المكاسب) للشيخ مرتضى الأنصاري، فكتب من هذه الكتب: كتاب (الطهارة)، وكتاب (الصلاة) وطرحها للتقييم والتجربة من أجل اكتشاف نقاط الضعف فيها، حتى إذا تم له ما أراده لتجربته من نقد وتقييم شرع بتتمة مشروعه الفقهي البديل. واضعا نصب عينيه في خطته المرسومة لهذا البديل أن يكون حاويا على بعض كتب قسم
ص: 355
العبادات كالطهارة والصلاة والصوم، ثم على بعض كتب قسم المعاملات وهكذا، فهو لا يشتمل على جميع كتب أبواب الفقه لأنه يوجب التطويل والمفروض مرور الطالب في الكتاب السابق على دورة فقهية كاملة، كما أنه لا يختص بباب المعاملات كما عليه كتاب مكاسب الشيخ الأعظم، لأن الطالب في مرحلة الخارج لا يحتاج فقط إلى باب المعاملات، بل ربما يواجه باب اطهارة أو باب الصلاة فيحتاج على هذا الأساس إلى مرور تفصيلي على أمهات كتب الأبواب الفقهية المختلفة(1) ذلك أن طالب البحث الخارج لم يسبق له أن درس فقه العبادات بمستوى بحث المكاسب لفقه المعاملات.
وقد أوضح المؤلف في مقدمته لكتاب الطهارة من فقه العبادات أن بديل كتاب المكاسب هذا يختلف عن بديل كتاب اللمعة الدمشقية السابق حيث أن المتن وبيان المستند هو الملحوظ فيما سبق، بينما لوحظ في هذا الكتاب العرض الموحد(2).
ولقد توخى مؤلف الكتابين البديلين لكتاب اللمعة الدمشقية والمكاسب في كتابيه الجديدين سهولة العرض، فهذه مشكلة كنا نعاني منها في كتبنا القديمة أعني صعوبة العرض وصعوبة إيصال المطالب إلى الطالب، وطرح الأساليب الجديدة في عملية الاستدلال، وعلى سبيل المثال فإن كتاب المكاسب وكتاب الروضة البهية لم يحتويا على بعض الأساليب الجديدة للاستدلال حيث لم تكن مألوفة في مثل هذه الكتب، وحاولت يقول الشيخ الإيرواني أن أشير إلى هذه الأساليب وأحدث ما توصل اليه علم الفقه في هذا المجال، وكذلك مسألة ربط الفقه بالأصول، فقد حاولت من هذه الناحية إيصال مدى الترابط الوثيق بين الفقه والأصول عمليا، وبهذا يتضح مقدار الحاجة إلى علم الأصول.
وهناك قضية ثالثة، وهي أننا عند دراستنا للكتب القديمة لا نتقدم خطوة إلى الأمام على طريق الاستنباط والاجتهاد، فنحن نحتاج إلى كتاب مربٍّ يعلمنا كيف نجتهد؟
ص: 356
وكيف نستنبط؟، وهذا ما لم نلمسه في دراستنا للكتب القديمة، وأنا شخصيا لمست هذه أثناء دراسة هذه الكتب، ولكن بعد أن رحت أقرأ بعض الكتب الأخرى(1).
بيد أن ذلك لا يعني أن كتاب (دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي) استطاع أن يحقق كامل غرض مؤلفه منه، فالكتاب لا زال بحاجة إلى خوض أكثر عمقا في ثنايا مطالبه المبحوثة، كما ان دارسه ربما يجد صعوبة غير قليلة في الإجابة عن أسئلة السائلين الفقهية، كون الكتاب لا يوفر لدارسه ملكة تطبيق الكبرى على الواقع وهي الملكة التي كانت توفرها له بدرجة معقولة دراسة كتاب اللمعة الدمشقية كما تقدم.
إضافة إلى عدم تناول كتاب (دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي) المسائل المستجدة التي بدأت تشغل بال المعنيين بدراسة الفقه كثيرا كعقد التأمين والاستنساخ وبعض مسائل الكومبيوتر والأنترنيت والعديد من مسائل المصارف والبنوك ومسائل كثيرة في الطب وفروعه من قبيل بعض المسائل المتعلقة بمرض الأيدز والبحث في مسألة مشروعية الإنجاب بالوسائل الصناعية كحقن المرأة بالسائل المنوي وزرع البويضة في الرحم وزرع الأعضاء التناسلية والبحث في مسألة موت الدماغ وبيع الأعضاء البشرية وضمان الطبيب والعديد من المسائل المتعلقة بالتجميل وتغيير هيئة الأعضاء والبحث في مسألة بيع السلم وتطبيقاته المستجدة وعقود التوريد والمناقصات والهندسة الوراثية وأمثالها كثير من المسائل المستحدثة الأخرى التي شاع الابتلاء بها هذه الأيام.
أورد الساعون لتأليف كتب جديدة لتحل محل الكتب القديمة في علم أصول الفقه مبررات عدة لدعوتهم تلك يمكن إجمالها فيما يأتي:
ص: 357
المبرر الأول : أن الأفكار الأصولية التي تناولتها الكتب الدراسية المعمول بها في هذه المرحلة الدراسية تعينا لا تعيينا قد تخطاها علم أصول الفقه وتجاوزها بمراحل فكتاب (المعالم) وهو أول كتاب يدرسه الطالب أصبح اليوم جزءا من مرحلة قديمة تاريخيا من علم الأصول، و (القوانين) تمثل مرحلة خطاها علم الأصول واجتازها إلى مرحلة أعلى على يد الشيخ الانصاري وغيره من الاعلام، و (الرسائل) و(الكفاية) نفسهما نتاج أصولي يعود لما قبل مائة سنة تقريبا وقد حصل علم الأصول بعد الرسائل والكفاية على خبرة مائة سنة تقريبا من البحث والتحقيق على يد اجيال متعاقبة من العلماء المجددين، وخبرة ما يقارب مائة سنة من البحث العلمي الأصولي جديرة بأن تأتي بأفكار جديدة كثيرة وتطور طريقة البحث في جملة من المسائل وتستحدث مصطلحات لم تكن تبعا لما تتكون من مسالك ومبان، ومن الضروري ان تنال الكتب الدراسية حظا مناسبا لها من هذه الافكار والتطورات والمصطلحات لئلا يفاجأ بها الطالب في بحث الخارج دون سابق إعداد. وهكذا يوجد الآن فاصل معنوي كبير بين محتويات الكتب الدراسية الاربعة وبين ابحاث الخارج، فبينما بحث الخارج يمثل حصيلة المائة عام الاخيرة من التفكير والتحقيق ويعبر بقدر ما يتاح للأستاذ من قدرة عن ذروة تلك الحصيلة، نجد ان كتب السطح تمثل في أقربها عهدا الصورة العامة لعلم الأصول قبل قرابة مائة عام ساكتة عن كل ما استجد خلال هذه الفترة من أفكار ومصطلحات.
المبرر الثاني : ان الكتب الاربعة السالفة الذكر على الرغم من انها استعملت ككتب دراسية منذ اكثر من خمسين عاما لم تؤلف من قبل اصحابها لهذا الهدف، وانما ألفت لكي تعبر عن آراء المؤلف وافكاره في المسائل الأصولية المختلفة، وفرق كبير بين كتاب يضعه مؤلفه لكي يكون كتابا دراسيا وكتاب يؤلفه ليعبر فيه عن أعمق وأرسخ ما وصل اليه من افكار وتحقيقات، لان المؤلف في الحالة الأولى يضع نصب عينيه الطالب المبتدئ
ص: 358
الذي يسير خطوة فخطوة في طريق التعرف على كنوز هذا العلم واسراره، واما في الحالة الثانية فيضع المؤلف في تصوره شخصا نظيرا له مكتملا من الناحية العلمية ويحاول ان يشرح له وجهة نظره ويقنعه بها بقدر ما يتاح من وسائل الاقناع العلمي.
المبرر الثالث: ان المقدار الذي ينبغي ان يعطى من الفكر العلمي الأصولي في مرحلة السطح يجب ان يحدد وقفا للغرض المفروض لهذه المرحلة، والذي أعرفه غرضا لهذه المرحلة تكوين ثقافة عامة عن علم الأصول لمن يريد ان يقتصر على تلك المرحلة، والاعداد للانتقال إلى مرحلة الخارج لمن يريد مواصلة الدرس وهذا هو أهم الغرضين فلا بد إذن ان يكون المعطى بقدر يكفل ثقافة عامة تحقق هذا الاعداد وتوجد في الطالب فهما مسبقا بدرجة معقولة لما سوف يتلقى درسه من مسائل ومرتبة من العمق والدقة تتيح له ان يهضم ما يواجهه في ابحاث الخارج من افكار دقيقة موسعة وبناءات فكرية شامخة، ومن الواضح ان هذا يكفي فيه ان توفر الكتب الدراسية على اعطاء علم الأصول بهيكله العام، ولا يلزم ان يمتد البحث في تلك الكتب إلى التفريعات الثانوية ويتلقى وجهات نظر فيها بل الافضل ان تترك هذه التفريعات على العموم إلى ابحاث الخارج ما دامت المفاتيح التي سوف يتسلمها الطالب كافية لمساعدته على الدخول فيها بعد ذلك مع أستاذ بحث الخارج.
هذا فضلا عن الاستطرادات التي وقعت فيها تلك الكتب كاستطرادها للحديث عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك، او التوسعات التي تزيد عن الحاجة لمرحلة السطح في استعراض الاقوال ونقل الادلة واستيعاب النقض والابرام حتى بلغت الاقوال التي احصاها (الشيخ في الرسائل في الاستصحاب) وبحث كل واحد منها بحثا مفصلا اربعة عشر قولا.
المبرر الرابع: ان الطريقة المتبعة في تحرير المسائل وتحديد كل مسألة بعنوان من
ص: 359
العناوين الموروثة تاريخيا في علم الأصول لم تعد تعبر عن الواقع تعبيرا صحيحا، وذلك لان البحث الأصولي من خلال اتساعه وتعميقه بالتدريج منذ ايام الوحيد البهبهاني إلى يومنا هذا طرح قضايا كثيرة جديدة ضمن معالجاته للمسائل الأصولية الموروثة تاريخيا، وكثير من هذه القضايا تعتبر من الناحية الفنية ومن الناحية العملية معا اهم من جملة من تلك المسائل الموروثة، بينما ظلت هذه القضايا تحت الشعاع ولا تبرز إلا بوصفها مقدمات او استطرادات في مباحث تلك المسائل(1).
وكمثل تطبيقي على عدم إلمام كتاب الكفاية مثلا بكل المسائل الأصولية اللازمة لمتطلبات عملية الاستنباط إضافة لوجود ما لا علاقة له بعملية الاستنباط في الكفاية مما يحمل الطالب أثقالا إضافية ووقتا وجهدا غير لازمين لتحقيق غايته العلمية فإننا لو رجعنا إلى كتب الفقه الاستدلالية كالرياض والمسالك والمستند والجواهر وأمثالها، وتتبعنا وبدقة القواعد الأصولية المستخدمة فيها، ثم وبعد استخلاصها منها ووضعها في قائمة نقوم بمقارنة بينها وبين محتويات كتاب الكفاية رأينا أن جملة مما يذكر في الكفاية لا علاقة له بالاستنباط والاجتهاد وأن جملة مما له علاقة بالاجتهاد والاستنباط غير موجود في الكفاية ولأقل هو غير موجود وبعنوانه وباحتواء كل أطرافه كقاعدة الظهور وقاعدة الجمع العرفي والدلالي(2).
ونظرا لملاحظات عدة اقنعت المصلح المجدد بأهميتها بذل سماحة الشيخ محمد رضا المظفر جهده في تأليف كتابه (أصول الفقه) كما تقدم ليشكل حلقة وسطى بين كتابي (المعالم) و(الكفاية) مقسما فيه أبحاث علم الأصول إلى اقسام أربعة متبعا في ذلك منهجة شيخه سماحة الشيخ محمد حسين الأصفهاني (قدّس سِرُّه) الذي تبناه في دورة بحثه الأصولية الأخيرة وهي:
1. مباحث الألفاظ: وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامة
ص: 360
نظير البحث عن صيغة أفعل في الوجوب وظهور النهي في الحرمة ونحو ذلك.
2 - المباحث العقلية : وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة للفظ كالبحث عن الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع.
3 - مباحث الحجة : وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، كالبحث عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر وحجية ظواهر الكتاب وحجية السنة والاجماع والعقل وما إلى ذلك.
4 - مباحث الأصول العملية وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي، كالبحث عن اصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها.
فمقاصد الكتاب إذاً أربعة. وله خاتمة تبحث عن عوارض الأدلة وتسمى: مباحث التعادل والتراجيح فالكتاب يقع في خمسة أجزاء(1). ثم عاد الشيخ (قدّس سِرُّه) فاستدرك بعدئذ فوضع كتابه في أربعة أجزاء حيث ألحق (مباحث التعادل والتراجيح) بالجزء الثالث ضمن مباحث الحجج كونه كما قال (قدّس سِرُّه) في مقدمة الباب التاسع : أليق شيء بها، لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة (2).
ورغم وجود إيجابيات كثيرة لمحاولة شيخنا المظفر في (أصول الفقه) يأتي في مقدمتها حرصه الموفق على تبسيط أصول هذا الفن لطلاب السطوح كي يعينهم على خوض غمار بحره المتلاطم مع براعة لا يقدر عليها إلّا من أوتي قوة في التعبير وسلاسة في العرض يستطيع من خلالهما أن يوصل المعني العلمي الدقيق بعبارة سلسة وهو ما كان يفتقده المنهج الدراسي المتبع لعلم الأصول في هذه المرحلة ذلك ان الكتب الدراسية لا تحتوي على الصعوبة والتعقيد في الجانب المعنوي والفكري منها فقط، بل انها تشتمل على الصعوبة والتعقيد في الجانب اللفظي والتعبيري أيضا ولهذا تجد عادة ان المدرس
ص: 361
حتى بعد ان يشرح الفكرة للطالب تظل العبارة مستعصية على الفهم ويحس الطالب بالحاجة إلى عون الأستاذ في سبيل تطبيق تلك الفكرة على العبارة جملة جملة، وليس ذلك إلّا لأن العبارة قد طعمت بشئ من الالغاز، إما لإيجازها أو للالتواء في صياغتها أو لكلا الأمرين(1) معا حتى قال قائلهم في شكوى مريرة ضمنها مقاله الذي كتبه ونشره عام 1913م / 1331ه إن كتاب كفاية الأصول : عبارته مغلقة للغاية وقال طالب آخر باثا معاناته من التعقيدين اللفظي والمعنوي بما نصه: وصلت في دراستي الحوزوية على الطريقة القديمة في الدراسة إلى كتاب كفاية الأصول الذي صدمني بتعقيده ورموزه وسوء تعبيره، مما يولد في نفسي رد الفعل عن مواصلة دراسة هذا العلم(2).
إن قدرة الشيخ المظفر (قدّس سِرُّه) المشهود لها في أوساط الحوزات العلمية هي التي مكنته من الجمع في كتابه بين سهولة العبارة وسلاستها من ناحية، والاختصار المحسوب بدقة من ناحية ثانية، وجميل انتقائه لآخر ما وصلت اليه بحوث مدرسة النجف الحديثة في علم الأصول من ناحية ثالثة، وجديد منهجته في تصنيفه للمباحث الأصولية من ناحية رابعة، تلك التي تجلت بإضافة باب جديد هو (مباحث الحجج) إلى مباحث هذا العلم وبحثه مستقلا في باب مستقل، في حين كانت الموضوعات التي بحثها في هذا الباب تبحث عند سابقيه ضمن موضوعات أخرى كالقطع والظن كما في كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري(3).
إن هذه الأمور الأربعة وغيرها هي التي أعطت لكتاب الشيخ المظفر هذه الخصيصة فجعلته خلال فترة زمنية ليست بالطويلة يحتل دوره البارز من بين كتب الدراسة والتدريس المعتمدة لهذا العلم في أوساط الحوزة العلمية النجفية، بل وفي الحوزات العلمية في شرق الأرض وغربها كافة.
بيد أن ذلك لا يعني عدم وجود بعض الملاحظات التي وردت عليه يأتي في مقدمتها
ص: 362
عدم استيعابه للمطالب الأصولية حيث لم يتسن له كتابة الأصول العملية عدا بعض مباحث الاستصحاب لا كلها، ولأنه خرج في كثير من أبحاثه عن أن يكون مقدمة الدراسة كتاب الكفاية، فقد توسع في بعضها بما هو أعمق وأحدث من مطالب الكفاية كما في مبحث (التمسك بالعام في الشبهة المصداقية واعتبارات الماهية من بحث المطلق والمقيد، والتحسين والتقبيح العقليين، وكذا أغلب مباحث الملازمات العقلية غير المستقلة، وبحثه في موضوع الاستصحاب) وكثير من تنبيهاته إلى غير ذلك مما يلاحظه المطلع العارف. وهو (رَحمهُ اللّه) وإن علل ذلك في بعض المباحث بأن المفروض في الطالب أنه قد وصل إلى مرتبة من العلم يسهل معها استيعابه لما يعرض عليه من مطالب. فإن الإحاطة بكثير من هذه المباحث بالصورة التي عرضها (رَحمهُ اللّه) تجعل الطالب اسبق بمرحلة أو مراحل مما يمر عليه في الكفاية، فكيف يا ترى والحال هذه يكون الكتاب مقدمة لدراستها(1)، إضافة إلى أن المنهج الدراسي المتبع في الحوزة العلمية يفرض على الطالب دراسة كتابي (الرسائل) و (الكفاية) قبل انتقاله إلى مرحلة البحث الخارج وهنا يشعر الطالب بفجوة بين ما قرأه في كتاب المظفر وما يقرؤه في كتاب الرسائل أو الكفاية من حيث الأسلوب والمنهجة والألفاظ، وهذا ما يشكل عائقا للطالب، فلو أن الشيخ المظفر كتب كتابا قبل أصول المظفر وكتابا بعده بحيث تصبح هذه الكتب حلقات متدرجة ينتقل فيها الطالب بشكل تدريجي فإنه لن يشعر بهذه الفجوة، مضافا إلى وجود بعض نقاط الضعف في هذا الكتاب من قبيل وجود بعض الزوائد التي كان يمكن الاستغناء عنها(2).
وليس هذا الإشكال موجها لكتاب الشيخ نفسه كما يبدو، بل هو موجّه لقناعة الشيخ أو الظرفه كونه لم يتم تأليفه النافع في أصول الفقه بما يسبقه ويلحقه، ولو كان حصل ذلك لاستغنى الطالب بما كتب الشيخ المظفر عن دراسة الكتب الأخرى في هذه
ص: 363
المادة العميقة الغور. ولقد كان يمكن أن ينبري لهذه المهمة من هو مؤهل لحمل ثقلها من العلماء الأعلام المعاصرين أو اللاحقين له، ولا زال الوقت مناسبا لذلك على كل حال.
ثم كان أن تصدى لتأليف منهج دراسي في علم أصول الفقه سماحة الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدّس سِرُّه) فألف كتابه المعنون ب(دروس في علم الأصول) المعروف في أوساط الحوزويين ب(الحلقات)، وهو كتاب ذو ثلاث حلقات متدرجة تناولت المهم من المطالب الأصولية خصص الحلقة الأولى للمبتدئين في هذا العلم وخصص الثانية للمتوسطين منهم ممن قضوا وطرا في دراسته الأولية، وخصص الحلقة الثالثة لمن هم على ابواب دخول مرحلة البحث الخارج محاولا أن يتدرج في عرض المطالب الأصولية نفسها نحو الأوسع فالأوسع فالموضوع المبحوث في الحلقة الأولى مبسطا يعاود بحثه ثانية في الحلقة الثانية بشكل أوسع وهكذا في الحلقة الثالثة بشكل أكثر عمقا وشمولا ساعيا من خلال محاولته الثلاثية هذه إلى وضع منهج أصولي يستغني الطالب به عن دراسة غيره وينتقل بعد الانتهاء من حلقته الثالثة إلى البحث الخارج مباشرة آخذا بعين الاعتبار النقاط التالية:
أولاً : ان الهدف الذي جعلنا على عهدة الحلقات الثلاث تحقيقه وصممناها وفقا لذلك هو ما اشرنا اليه سابقا من ايصال الطالب إلى مرحلة الاعداد لبحث الخارج وجعله على درجة من الاستيعاب للهيكل العام لعلم الأصول ومن الدقة في فهم معالمه وقواعده تمكنه من هضم ما يعطى له في ابحاث الخارج هضما جيدا.
ثانياً : إن الحلقات الثلاث تحمل جميعا منهجا واحدا تستوعب كل واحدة منها علم الأصول بكامله ولكنها تختلف في مستوى العرض كما وكيفا وتتدرج في ذلك فيعطى لطالب الحلقة الأولى او الثانية قدر محدد من البحث في كل مسألة ويؤجل قدر آخر إلى المسألة من الحلقة التالية، ولم يتمثل التدرج في العرض في كل حلقة بالنسبة إلى
ص: 364
سابقتها بل تمثل ايضا في نفس الحلقة الواحدة وفقا لنفس الاسباب من الناحية الفنية، فالحلقة الثانية تتصاعد بالتدريج والحلقة الثالثة يعتبر الجزء الثاني منها اعلى درجة من الجزء الأول.
ثالثاً : إنا لم نجد من الضروري حتى على مستوى الحلقة الثالثة استيعاب كل الادلة التي يستدل بها على هذا القول او ذاك... لان هذه الاحاطة انما تلزم في بحث الخارج او في تأليف يخاطب به العلماء من اجل تكوين رأي نهائي فلا بد حينئذ من فحص كامل، واما في الكتب الدراسية لمرحلة السطح فليس الغرض منها كما تقدم إلا الثقافة العامة والاعداد.
رابعاً : إنا تجاوزنا التحديد الموروث تاريخيا للمسائل الأصولية وابرزنا ما استجد من مسائل واعطيناها عناوينها المناسبة، وهذا يمتاز على التصنيف الثنائي المشهور ويمتاز على التصنيف الرباعي الذي اقترحه المحقق الاصفهاني وسار عليه كتاب (أصول الفقه) اذ في كلا التصنيفين تفصل حجية الظهور وحجية السند عن ابحاث الدلالة بينما الجهات الثلاث متلاحمة مترابطة في عملية الاستنباط، فلكي يوحي التصنيف بصورة للقواعد الأصولية تتفق مع مواقعها في عملية الاستنباط لا بد من اتباع ما ذكرناه.
خامساً : إنا لاحظنا في استعراضنا لآحاد المسائل ضمن التصنيف المذكور الابتداء بالبسيط والانتهاء إلى المعقد والتدرج في عرضها حسب درجات تعقيداتها وترابطاتها، وحرصنا على ان لا نعرض مسألة إلا بعد ان نكون قد استوفينا مسبقا كل ما له دخل في تحديد التصورات العامة فيها، وان لا نعطي في كل مسألة من الاستدلال والبحث إلا بالقدر الذي تكون أصوله الموضوعية مفهومة بلا حاجة إلى الرجوع إلى مسألة لاحقة.
سادساً: وجدنا ان تعدد الحلقات شئ ضروري لتحقيق المنهج الذي رسمناه لان
ص: 365
إعطاء مجموع الكمية الموزعة للمسألة الواحدة في الحلقات الثلاث ضمن حلقة واحدة تحميل فجائي للطالب فوق ما يطيقه ويكون جزء من تلك الكمية عادة مبنيا على مسائل اخرى بعد لم يتضح للطالب حالها، بل انا وجدنا ان تثليث الحلقات شئ ضروري ايضا على الرغم من ان الحلقة الأولى يبدو انها ضئيلة الاهمية وقد يتصور الملاحظ في بادئ الامر امكان الاستغناء عنها نهائيا، ولكن الصحيح عدم امكان ذلك لاننا بحاجة قبل أن نبدأ بحلقة استدلالية تشمل على نقض وإبرام إلى تزويد الطالب بتصورات عن المطالب والقواعد الأصولية حتى يكون بالإمكان في تلك الحلقة الاستدلالية أن نضمن استدلالنا ونقضنا وإبرامنا لهذه المسألة أو تلك هذا المطلب الأصولي أو ذاك.
سابعاً: إن كل حلقة وان كانت تستعرض علم الأصول ومباحثه على العموم ولكن مع هذا قد نذكر بعض المسائل الأصولية او النكات في حلقة ثم لا نعيد بحثها في الحلقة التالية اكتفاءا بما تقدم لاستيفاء حاجة المرحلة اي مرحلة السطح بذلك المقدار.
ثامناً : انا لم ندخل على العبارة الأصولية تطويرا مهما ولم نتوخ ان تكون العبارة في الحلقات الثلاث وفقا لاساليب التعبير الحديث وانما حاولنا ذلك إلى حد ما في الحلقة الأولى فقط، واما في الحلقتين الثانية والثالثة فقد حرصنا ان تكون العبارة سليمة ووافية بالمعنى ولكن لم نحاول جعلها حديثة، ولهذا جاء التعبير في الحلقتين العاليتين مقاربا في روحه العامة للتعبير المألوف في الكتب العلمية الأصولية وإن تميز عنه بالسلامة والوضوح ووفاء العبارة بالمعنى.
تاسعاً أشرنا آنفا إلى انا حرصنا على سلامة العبارة وان تكون واضحة وافية بالمعنى ولكن هذا لا يعني ان تفهم المطالب من العبارة رأسا، وانما توخينا الوضوح والسلامة بالدرجة التي تضمن ان تفهم المطالب من العبارة في حالة دراستها على الأستاذ المختص بالمادة، لان الكتاب الدراسي لا يطلب منه التبسيط اكثر من ذلك كما هو واضح(1).
ص: 366
ولعل الشهيد الصدر (قدّس سِرُّه) آثر منهجة سماحة السيد محسن الأمين (قدّس سِرُّه) المتوفى سنة (1)، فألف وفقها كتابه الأصولي (دروس في علم الأصول) بحلقات ثلاث، مفضلا هذه المنهجة على سواها من مناهج تأليف الكتب الدراسية في العلوم المختلفة، ومنها علم أصول الفقه، فقد كان سبق أن اقترح السيد محسن الأمين أن يضع أفاضل العلماء في حوزة النجف الأشرف في كل علم ثلاثة كتب: مختصر ومتوسط ومطول، ويكون عليها مدار التدريس في مدرسة النجف الكبرى وتتبعها سائر المدارس في أقطار البلاد(2) بعد أن رأى كتب الأصول المتداول قراءتها كالمعالم والقوانين والرسائل والكفاية محتاجة إلى التهذيب(3).
بيد أن كتاب الحلقات رغم غناه العلمي وبخاصة في حلقته الثالثة، لا يخلو كمنهج تدريسي من إشكالات عدة يأتي في مقدمتها:
:أولاً : إن المصطلحات الأصولية الواردة في كتاب الحلقات بعيدة عن المصطلحات المتعارفة في كتب علم الأصول الأخرى والسائدة في كتابات الأصوليين الآخرين من أعمدة هذا العلم وأساتذته وباحثيه مما ولِّد هوة فاصلة بين دارس كتاب الحلقات والمتتبع لمصادر علم الأصول الأوسع فيما لو رغب الطالب بمواصلة دراسته العليا المرحلة ما بعد كتاب الحلقات. ولطالما شعر دارس الحلقات بالغربة العلمية وهو يجوس خلال أبحاث علماء الأصوليين السابقين أو المعاصرين له. وهي مشكلة تربوية ليست هيئة على الطالب ولا على المخطط التربوي. إن هذه المصطلحات الجديدة أعاقت من سير هذا الكتاب ومن فتح الطريق له بسرعة(4).
ورغم أن السيد الشهيد الصدر (قدّس سِرُّه) كان ملتفتا إلى هذه المشكلة حين تأليفه لكتابه الحلقات ومستوعبا لأهميتها لاعتبارين كما نص على ذلك في المقدمة هما :
ص: 367
الاعتبار الأول : اننا اذا كتبنا الحلقات الثلاث بأساليب التعبير الحديث ووضعنا بديلا مناسبا عن المصطلحات القديمة فسوف تنقطع صلة الطالب بمراجع هذا العلم وكتبه ويتعسر عليه الرجوع اليها، وهذا يشكل عقبة كبيرة تواجه نموه العلمي. وعلى هذا الاساس اكتفينا من التجديد في اساليب التعبير الأصولي بما أنجز في الحلقة الأولى وانتقلنا بالطالب في الحلقتين العاليتين إلى ارضية لغوية قريبة مما هو مألوف في كتب الأصول.
والاعتبار الآخر ان الكتب الدراسية الأصولية والفقهية المكتوبة باللغة العربية تتميز عن أي كتاب دراسي عربي في العلوم المدنية بأنها كتب لا تختص بأبناء لغة دون لغة، وكما يدرسها العربي كذلك يدرسها الفارسي والهندي والأفغاني وغيرهم من أبناء الشعوب المختلفة في العالم الإسلامي على الرغم من كونها كتبا عربية، وهؤلاء يتلقون ثقافتهم العربية من المصادر القديمة التي لا تهيئ لهم قدرة كافية لفهم اللغة العربية بأساليبها الحديثة، فما لم يحصل بصورة مسبقة تطوير وتعديل في اساليب تثقيف هؤلاء وتعليمهم اللغة العربية يصعب اتخاذ اساليب التعبير الحديث اساسا للتعبير في الكتب الدراسية الأصولية(1). إلّا أنه (قدّس سِرُّه) مع ذلك لم يستطع كما يبدو تجاوز هذه المشكلة حس تشخيص مدرسي هذه المادة.
يقول سماحة الشيخ باقر الإيرواني في معرض تقييمه لوجود هذه المصطلحات الجديدة في كتاب الحلقات بأنها مشكلة يعاني منها الطالب(2).
ثانياً : إن السيد الشهيد (قدّس سِرُّه) لم يقتصر تغييره على الألفاظ والبيان، بل غيّر أيضا المنهجة فقدّم وأخر في المطالب، وهذا التقديم والتأخير والاختلاف في الترتيب السائد لعلم الأصول يؤثر على الطالب، يضاف إلى ذلك أمر آخر وهو أن الأسلوب المتبع في البحث الخارج قائم على ملاحظة الكتب القديمة، فالمدرسون في البحث الخارج
ص: 368
يلاحظون كتاب (الكفاية) وكتاب (الرسائل) فيبقى الطالب مرتبطا بهذين الكتابين ولن يفك ارتباطه بهما. وعلى هذا الأساس يبقى الطالب ينظر بعين إلى ما ألفه السيد الشهيد وبعين أخرى إلى هذين الكتابين، ولذلك نرى أن الأخوة في الحوزة العلمية لا يستغنون عن هذه الكتب ودراستها وإن كانوا يحبون ذلك(1).
ثالثاً : إن الحلقات بما في ذلك الحلقة الأعمق منها وهي الحلقة الثالثة ليست كافية كي تؤهل الطالب لينتقل منها إلى البحث الخارج مباشرة، رغم أن مادتها العلمية هي الأحدث في علم الأصول، فلو كان السيد الشهيد (قدّس سِرُّه) توسع أكثر في حلقاته بحيث تكون الجرعة الأصولية المستخلصة من الحلقات مساوية للجرعة الأصولية المستخلصة من الرسائل أو الكفاية لكان جمع في مباحث الأصول بين الأحدث والأصعب في آن.
وهناك غير هذه المشكلة وتلك من قبيل أن الحلقة الأولى تبدو كما لو كانت كتاب مطالعة متأنية وليست كتاب درس وتدريس ومباحثة كما هو دأب الطالب الحوزوي مع الكتب الدراسية المعمول بها، ومن قبيل ما يترتب على ذلك من عدم استطاعة الحلقات ردم الهوة العلمية الفاصلة بين الحلقة الأولى والحلقتين الثانية والثالثة، فبينما قد يكتفي الطالب الألمعي كما ينص السيد الشهيد (قدّس سِرُّه) في مقدمته لكتابه ان يمر على الحلقة الأولى مرورا سريعا مع الأستاذ او يقرأها بصورة منفردة ويراجع الأستاذ في بعض النقاط منها كما كنت أرى وأسمع من بعضهم وأشاهد خلال تدريسي لبعض مباحث الحلقات في الجامعة، يعسر على الألمعي نفسه في مرحلة السطوح استيعاب بعض مباحث الحلقة الثالثة مع الأستاذ والدرس إلا بعد جهد ولأي.
ولعل هذه الأسباب وغيرها وفي مقدمة ذلك أساليب النظام البائد الوحشية في محاربة الحوزة العلمية في النجف الأشرف بقسوة فائقة خلال فترة حكمه الطويلة ومنع تداول الحلقات وبقية تصانيفه (قدّس سِرُّه) في العراق مع محاسبة من توجد في حوزته حسابا
ص: 369
عسيرا فضلا عن مدرسيها ودارسيها هي ربما من بين الأسباب التي حالت بين الحلقات واتخاذها منهجا تدريسيا متبعا في حوزة النجف الأشرف العلمية حتى اليوم.
ثم كان أن ألف أخيرا سماحة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه) كتابه الأصولي المعنون (الكافي في أصول الفقه) في جزئين كبيرين ليكون الكتاب التدريسي الممهد لحضور مرحلة البحث الخارج، والبديل لكتابي : (الرسائل) للشيخ مرتضى الأنصاري (قدّس سِرُّه) وهو الكتاب الذي يتكفل ببحث القسم الثاني من الأصول، في القطع ومباحث الحجج والأصول العملية والتعارض بتفصيل واستيعاب و(كفاية الأصول) تأليف العَلَم الباني على تلك الأسس، المحقق الخراساني (قدّس سِرُّه)، وهو الكتاب الذي يستوعب بجزئيه دورة أصولية كاملة بعمق واختصار.
وقد عالج الكتابان الرسائل وكفاية الأصول كما يقول (دام ظلّه) في مقدمة كتابه الكافي مشاكل علمية سابقة، وتضمنا مطالب جديدة، وأرسيا قواعد جليلة ينهض عليها علم الأصول الحديث، وأدّيا دورا خطيرا مشكورا في خدمة الحوزة دراسيا وعلميا وصارت مطالبهما مدار البحث والتحقيق في مدة تقرب من قرن ونصف القرن للكتاب الأول وقرن للكتاب الثاني(1).
ويضيف المرجع السيد الحكيم(2) قائلاً غير أن تطور العلم في هذه المدة الطويلة بفضل أعلام التحقيق الذين برزوا على الساحة يفرض الحاجة لكتاب يخلفهما ليتناسب مع ذلك التطور المشرِّف، ويحاول التخلص من سلبيات الكتابين، وأهمها عدم تناسبهما في العرض، وعدم وفاء الكتاب الأول بدورة أصولية كاملة، والاختصار المشفوع بالتعقيد وغموض البيان في الثاني، وقد زاد كتاب الكافي في أصول الفقه على كتاب (رسائل) الشيخ الأنصاري بما يقرب من الثلث كما زاد عليه ببحث لم يتضمنه وهو القسم الأول من الأصول في مباحث الظهورات اللفظية والملازمات العقلية، وقد
ص: 370
استوعب دورة أصولية كاملة متناسقة في التبويب والعرض والتعبير.
وقد حاولنا فيه تهذيب الأصول من النظريات القديمة والمباحث غير المجدية، أو التخفيف في بحثها بما يتناسب وأهميتها، والتركيز على المطالب المستجدة نتيجة التطور المثمر الذي حصل في هذه المدة الطويلة.
وربما يرد على الكتاب المذكور توسعه في بعض المطالب، وصعوبة تعابيره، وإيجاز بیانه بنحو قد يحتاج استيعاب المقصود منه إلى تكلّف لا يسع الكثيرين.
أما ما يتعلق بإضافة مادة جديدة لمنهج علم أصول الفقه المتبع حاليا في مرحلة السطوح فقد باتت ضرورية لطالب هذه المرحلة، وفي هذا العصر بالذات، وربما قبله أيضا، ولكن باتت الحاجة اليه أكثر إلحاحا في هذا الزمن الذي أصبح العالم فيه فضلا عن بلاد المسلمين قرية واحدة فقد الّف سماحة السيد محمد تقي الحكيم كتابه (الأصول العامة للفقه المقارن) ليضاف إلى منهج علم أصول الفقه المتبع في الحوزة العلمية أو ليحل محل بعض الكتب القديمة كما يرى بعض أساتذة الحوزة العلمية، محاولا بذل جهده كي يجدد في علم الأصول من زوايا عدة منها :
أن مؤلفه بوّب كما يقول الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي الكتاب تبويبا منهجيا سليما ترابطت فيه موضوعات هذا العلم ترابطا عضويا وترتبت ترتيبا أخذ كل موضوع فيه موضعه الطبيعي من الكتاب والمنهجية عند أستاذنا المؤلف ميزة تفرّد بها في حدود اطلاعي من بين أقرانه من علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ويرجع هذا فيما أقدّر إلى عاملين هما :
1 - موهبة التنظيم التي منحها اللّه إياه.
2 - قراءاته الكثيرة والمتنوعة التي نمت عنده هذه الموهبة وصقلتها صقلا مميزا آتي
ص: 371
ثماره فيما كتب من بحوث ورسائل وكتب.
بدأ كتابه بالباب التمهيدي الذي عرّف فيه الفقه المقارن و أصول الاحتجاج و أصول الفقه المقارن ثم بمباحث الحكم وختم الباب بعرضه لمنهج البحث الذي سيسلكه في دراسته هذه(1). قائلا : إننا بعد استقرائنا لمختلف الكتب الفقهية والأصولية لدى أئمة ومجتهدي المذاهب فيما وقع منها بأيدينا رأينا، أن نخرج على الطريقة التقليدية فنبوبه على أساس ما لبعض هذه الأبواب من تقدم رتبي على بعضها الآخر وخلص لنا من ذلك أن أبواب الكتاب ستكون خمسة:
1. ما يكون سمته سمة الكاشف عن الحكم الواقعي.
2. ما يكون سمته سمة المحرز للواقع تنزيلا.
3. ما يكون مثبتا للوظيفة الشرعية.
4. ما يكون مثبتا للوظيفة العقلية.
5. ما يكون رافعا للأمور المشكلة بعد تعقدها وفقد الدليل عليها، وأبعدنا عن طريقنا كل ما لا ينتج الحكم الكلي من الكبريات وكلما يقع موقع الصغرى من قياس الاستنباط(2).
وهو بهذا التبويب جمع جميع الأصول أو قل الأدلة الفقهية التي وضع هذا العلم لالتماس أدلتها التي تثبت مشروعيتها وتمنحها حجيتها.
وبتعبير آخر اقتصر الكتاب على استعراض الكبريات (القواعد الأصولية) دون إدخال صغرياتها حريم البحث، ذلكم الادخال الذي أوقع الدرس الأصولي في غير موضع منه، في مفارقة الخلط بين الكبريات والصغريات، وهي التفاتة منهجية من
ص: 372
أستاذنا المؤلف موفقة غاية التوفيق(1).
ويذهب الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي(2) إلى أن السيد محمد تقي الحكيم استطاع أن ينهج في دراسة النص منهجا تكامليا مختلفا جمع فيه بين المنهج اللغوي الاجتماعي والمنهج الكلامي، والمقصود بالمنهج اللغوي الاجتماعي هو رجوع العالم الأصولي في دراسة دلالة الألفاظ إلى اللغة الاجتماعية وهي تلك الألفاظ المستعملة في حوار وتفاهم أبناء المجتمعات. والمقصود بالمنهج الكلامي هو اعتماد العالم الأصولي على مبادئ وقواعد علم الكلام فينطلق لوضع القاعدة من تطبيق معطيات علم الكلام على الظواهر التي يحاول استفادة القاعدة منها. وهذا المنهج الكلامي غطّى جميع موضوعات مباحث الألفاظ في كتب الأصوليين منذ عهد ذريعة السيد المرتضى وعدة الطوسي حتى كفاية الخراساني وهو أيضا أقدم منهج أصولي اعتمدته المؤلفات الأصولية واغرقت في استخدامه إغراقا كان ملحوظا وملاحظا عليها أي حتى في المفردات والتراكيب والأساليب أمثال الحقيقة والمجاز والأوامر والنواهي والعموم والخصوص وهي المواد التي تحدد قواعدها بالظهور اللفظي. والمفروض منهجيا لأننا في أصول الفقه ندرس النصوص الشرعية من آيات وروايات وهي نصوص عربية أن ندرسها من واقع الاستعمال العربي الاجتماعي لا أن نخضعها لمبادئ كلامية وذلك لأن اللغة من الاعتباريات ومبادئ علم الكلام قواعد عقلية مسرحها التكوينات لا الاعتباريات.
ولكل من هذين المنهجين إيجابيات وسلبيات فكان لابد والحالة هذه من اكتشاف منهج جديد يجمع بين المنهجين المتقدمين وهو ما أسماه الشيخ الفضلي بالمنهج التكاملي، وعنى به التفصيل في دراسة النص الشرعي بين القواعد وتفاصيل القواعد ففي القواعد نرجع إلى الدليل العقلي في إثبات حجية القاعدة التي ترتبط بالنص
ص: 373
الشرعي، وهي المتمثلة في حجية خبر الثقة، وحجية ظهور الألفاظ، وتشخيص مراد المتكلم، وفي تفاصيل القواعد نرجع إلى العلوم اللغوية العربية، والى تاريخ الحضارة العربية في عصر التشريع(1).
ومثل له بتفسير آية النبأ لإثبات حجية خبر الثقة عند كل من سماحة الشيح محمد رضا المظفر في كتابه أصول الفقه(2). وسماحة السيد محمد تقي الحكيم في كتابه الأصول العامة في الفقه المقارن، حيث ربط السيد محمد تقي الحكيم النص بواقع حادثة نزول الآية الكريمة باعتباره قرينة موضحة لدلالة الآية واتخذ من سياق الآية في إطار ترتيب ألفاظها وترابط معانيها قرينة في إفادة المعنى المطلوب ثم قام بتطبيق قاعدة الشرط الأصولية ليسلمه ذلك إلى النتيجة المقصودة، وهذا المنهج كما ترى منهجا تكامليا جمع بين الفهم العرفي والحس اللغوي والطريقة الكلامية في الاستدلال(3)، وفي دلالة حديث الثقلين على عصمة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) يستخدم المؤلف المنهج اللغوي لاستيحاء العصمة من حاق تعبير النص ثم بالاخرة يستخدم المنهج الكلامي تلميحا اليه وإشارة إلى معطياته في هذا المقام(4)، وفي مبحث الاستحسان يناقش المؤلف استدلال المثبتين له بالكتاب العزيز نقاشا اعتمد فيه المنهجين اللغوي والكلامي متكاملين لينتهي إلى أن ما استدل به من الآية الكريمة لا يفيد المدعى(5)، وفي موضوع القرعة(6) وهو يستعرض أدلتها من الكتاب يدخل العنصر التاريخي في البحث بشكل واضح وعلى أساس مبدأ مقارنة الأديان (الشرائع) فيما يسوغ لنا الأخذ به منها وما لا يسوغ، وعلى هذا المنهج من الجمع بين مختلف عناصر المنهج من لغوية وتاريخية وكلامية ومقارنة أديان وسواها سار أستاذنا الكبير في دراسته لقضايا علم أصول الفقه وقواعده سالكا كل عنصر فيما يناسبه بثقة ووعي وبهذا يكون لسيدنا الحكيم القدح المعلّى في هذه الريادة وهذا التطوير باستكماله كل متطلبات المنهج الجديد وريادته التأليف في أصول الفقه المقارن الذي هو
ص: 374
من ضروريات الدراسة الشرعية الإسلامية للوصول إلى الحق ومعرفة الحقيقة(1).
كما انه استكمالا لمنهجه التكاملي المتقدم استطاع أن يخوض غمار البحث اللغوي الأصولي ايضا بعمق وجدة وحداثة رؤية وأصالة.
يقول الشيخ محسن الأراكي إن ما تميز به السيد محمد تقي الحكيم على صعيد البحث اللغوي الأصولي دوره الرائد في معالجة الأبحاث اللغوية الأصولية بروح لغوية وبرؤية علمية جديدة وعرضها على طاولة البحث اللغوي في المجامع العلمية اللغوية، فإنه أول من فتح على اللغويين باب هذه الأبحاث وهو أبرز من تصدى من الأصوليين المحدثين للبحث المستقل عن المسائل اللغوية الأصولية مؤكدا على طابعها اللغوي الصرف أولا، وموضحا عمق الأبحاث التي خاضها الأصوليون في هذا المجال وسعتها ثانيا، ولافتا نظر العلماء اللغويين إلى أهمية هذه الأبحاث والى ضرورة اطلاعهم عليها وإفادتهم منها، بل وخوضهم فيها ثالثا(2).
ورغم ما تقدم من مزايا كتاب (الأصول العامة للفقه المقارن) وكونه أيضا قد طوّر من خلال أسلوب عرض مسائل علم الأصول التي لم يتجدد أسلوب عرضها، فضلا عن أن يضاف اليها منذ وقت ليس بالقصير(3) فإنه لم يسلم من النقد والملاحظة شأنه شأن الكتب الأصولية السابقة عليه، حيث رأى بعض المعنيين بدراسة مناهج الكتب الأصولية أن (الأصول العامة) يتضمن نصف دورة أصولية(4) لا دورة كاملة، لعدم تطرقه ل (مباحث الألفاظ) وهي المباحث التي تستغرق مساحات ليست بالقليلة من كتب الأصول السابقة عليه، وما ذاك إلّا لكونه لا يذهب إلى أن (مباحث الألفاظ) هي من مسائل علم الأصول، وقد صرح بذلك في كتابه حين تحدث عن منهجته فأشار بجلاء إلى أنه لا يبحث فيه إلّا ما يصلح أن يسمى أصلا للفقه هو خصوص الكبرى المنتجة لأنها هي التي تصلح للارتكاز عليها كقاعدة لبناء الاستنباط(5) ومباحث
ص: 375
الألفاظ هذه ليست منها فالأنسب اعتبارها من المبادئ وبحثها على هذا الأساس مع تقليص بحثها إلى ما تمس الحاجة اليه من حيث تشخيص دلالاتها اللغوية وإقصاء كل ما لا يمت إلى واقعها اللغوي من البحوث الفلسفية وغيرها(1) بصلة، خلافا للسائد حتى اليوم في كتب الأصول الأخرى، وهو ما اعتبره البعض الآخر من الباحثين ميزة منهجية تحسب له لا عليه.
هذا ويرى بعض المعنيين بدراسة مناهج علم أصول الفقه أهمية أن يعد كتاب (الأصول العامة للفقه المقارن) منهجا دراسيا معتمدا في الحوزات العلمية مضافا لمنهج أصول الفقه المعتمد فيها حاليا أو ليكون حلقة وسطى بين المعالم والكفاية، أو بدل الرسائل، أو مع الجزئين الأول والثاني من أصول الفقه للمظفر بدل الرسائل والكفاية(2).
وقد علل السيد محمد صادق الخرسان(3) أحد أساتذة حوزة النجف الأشرف تفضيله المزج بين تدريس الكتابين بقوله : فلما وجدت افتقار دارسي كتاب (أصول الفقه) للمرحوم آية اللّه الشيخ محمد رضا المظفر (ت 1383 ه/ 1964م) لما يكمل لهم دورة أصولية تامة حيث خلا من بقية مباحث الاستصحاب وجلّ تنبيهاته والأصول والأصول العملية الثلاث فيدرج الطالب الحوزوي نحو كتاب (الرسائل) للشيخ الأعظم الأنصاري (ت 1282 ه/ 1865م) أو كتاب (الكفاية) للشيخ المحقق الخراساني (ت1329ه / 1911م) وهو لمّا يتأهل في هذه المباحث المهمة، بل يلاحظ عدم غناء البعض من دارسيهما مما يشكل نقطة ضعف في الذهنية الأصولية لديه يلزم تلافيها فضلا عن التفكر في مساويها، فانعقد العزم على اختيار كتاب (الأصول العامة للفقه المقارن) ليكون عوضا لما لم يصل الينا من الشيخ المظفر بسبب إدراك الأجل أو لكثرة المشاغل المهمات، ولذا كان يحيل على كتاب الأصول العامة.
ص: 376
وأضاف لسببه سالف الذكر أسبابا أخرى قال إنها جعلتني أفضل استلال هذه المباحث الثلاث المشار اليها من كتاب (الأصول العامة للفقه المقارن) وتدريسها، وقد أعجب بفكرة التعويض هذه البعض فعمل على تطبيقها ويمكن تلخيص الأسباب والمميزات في :
1 - إن كلّا من الآيتين الرضا والتقي متقاربان فكريا، حيث تجمعهما قواسم مشتركة في طريقة التفكير وإيجاد الحلول والسير في سبيل تنفيذ الإصلاحات التي أراداها لطريقة الدرس الحوزوي.
2- إن كتاب (أصول الفقه) أعدّ كمحاضرات لطلبة السنتين الأولى والثانية في كلية الفقه، كما أن كتاب (الأصول العامة) أعدّ كمحاضرات لطلبة السنتين الثالثة والرابعة وقد أريد لهما أن يتوحدا ضمن المنهجية الأصولية في الكلية.
3- سبك العبارة في كتاب (الأصول العامة) بما يؤهلها لتكون نصا منهجيا يدرّس في المعاهد العلمية عامة، فهي رصينة لفظا، دقيقة معنى، وهذا عنصر مهم ينبغي الحرص على توافره فيما يختار لغرض التدريس المنهجي، إذ تفتقر بعض النصوص المعروضة للتدريس لهذا العنصر مما يوجب مللا لدى البعض، أو ابتسارا في الفهم لدى البعض الآخر، ولذا قد تطوى بعض المراحل من دون استيعاب وهو ما ينعكس سلبا على البنية الأصولية العامة لدى الطالب الذي يفترض فيه الاتقان والبحث عن الأصالة وعدم التعجل.
4- إن كتاب (الأصول العامة) يساعد على توافر طالب العلم الحوزوي على مفردات مقارنة لم يألفها، فهو أداة يتوخى منها الخير للنهوض بالمستوى العلمي ليحرز التقدم الموسوعي أو لينشط الاتجاه المقارن، وكلاهما يفيدان ويطوران كثيرا، وإن أدنى ما
ص: 377
يفيدانه هو بعث الاتصال الفكري من جديد بين فقهاء بل مفكري المذاهب الإسلامية عامة(1).
بيد أن الكتاب رغم تدريسه من قبل بعض أساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة وغيرهما ووضعه ضمن الكتب التي يدرسها الطالب القادم من الخارج للدراسة في حوزة قم المقدسة كي يرتقي السلم الموصل للاجتهاد وفق البرنامج المعد لذلك، ورغم اعتماده في العديد من الكليات المتخصصة بدراسة علوم الشريعة الإسلامية سواء ما كان منها في الدول العربية والإسلامية أم في الدول الأوربية أم غيرها إلا أنه ما زال في بداية الطريق ليكون منهجا دراسيا معتمدا كثير الشيوع والانتشار في حوزة النجف الأشرف.
ص: 378
(1) الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. سابق : 107.
(2) النظام التعليمي في الحوزة العلمية / 2. الشيخ عبد الجبار الرفاعي بحث. مجلة الفكر الإسلامي. العدد الثاني من السنة الأولى 1414 ه / 1993م. ص : 256 - 257
(3) الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد. الشهيد السيد محمد باقر الصدر بحث. مجلة فقه أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) العدد الأول السنة الأولى. 1416 ه / 1995م. ص : 15 - 18.
(4) المصدر السابق : 19 - 20.
(5) دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري الشيخ باقر الإيرواني 7.
(6) من مقدمته لكتاب اللمعة: 1/ 11.
(7) دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري سابق: 7.
(8) دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. الشيخ باقر الإيرواني: من مقدمة القسم الأول من الكتاب.
(9) دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري سابق : 7 8.
(10) المصدر السابق 9 - 10.
(11) دروس في الفقه الاستدلالي من فقه العبادات 1 كتاب الطهارة. الشيخ باقر الإيرواني: 9 - 10
ص: 379
(12) المصدر السابق : 10.
(13) حوار مع سماحة الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني سابق: 187 189.
(14) دروس في علم الأصول. الشهيد السيد محمد باقر الصدر.: 1/ 10 – 18 (باختصار).
(15) مآخذ على مناهج مرحلتي المقدمات والسطوح. د. الشيخ عبد الهادي الفضلي. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. سابق : 10 / 374.
(16) أصول الفقه. الشيخ محمد رضا المظفر: 1/ 7.
(17) المصدر السابق : 3/ 181.
(18) دروس في علم الأصول. سابق: 1/ 25.
(19) شعراء الغري. على الخاقاني : 7/ 351.
(20) ينظر : منهج دراسة النص عند الأصوليين ودور السيد محمد تقي الحكيم في تطويره. د. عبد الهادي الفضلي. بحث منشور ضمن بحوث كتاب: السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف: 108.
(21) تاريخ وتطور الفقه والأصول في حوزة النجف الأشرف العلمية. سابق : 217.
(22) حوار مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني. سابق. ص 180.
(23) دروس في علم الأصول. سابق : 10 22-29.(باختصار).
(24) ولد في مدينة شقرا إحدى مدن الجنوب اللبناني سنة.
(25) معادن الجواهر السيد محسن الأمين: 1 / 45-46 نقلا عن السيد محسن الأمين في سيرة حياته. ملاحق أعيان الشيعة. السيد محسن الأمين: 22
(26) المصدر السابق نفسه.
(27) حوار مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني سابق: 181.
ص: 380
(28) دروس في علم الأصول. سابق: 27 - 28.
(29) حوار مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني. سابق: 181.
(30) حوار مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني. سابق: 181.
(31) الكافي في أصول الفقه السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: 1 / 8. وينظر : علم الأصول نظرة جديدة في مناهه الدراسية في حوزة النجف. سابق : 110 - 112.
(32) المصدر السابق.
(33) مهج دراسة النص عند الأصوليين ودور السيد محمد تقي الحكيم في تطويره. د. عبد الهادي الفضلي. بحث سابق : 116.
(34) الأصول العامة للفقه المقارن سابق : 87
(35) منهج دراسة النص عند الأصوليين ودور السيد محمد تقي الحكيم في تطويره. سابق: 117.
(36) ينظر المصدر السابق: 107.
(37) المصدر نفسه: 108.
(38) ينظر كتابه : أصول الفقه. سابق 2 / 64-67.
(39) ينظر كتابه الأصول العامة للفقه المقارن. سابق : 206 208.
(40) ينظر المصدر السابق: 166-167.
(41) ينظر المصدر نفسه 373-374.
(42) ينظر نفسه : 552.
(43) منهج دراسة النص عند الأصوليين ودور السيد محمد تقي الحكيم في تطويره. سابق : 117 - 124 ( باختصار).
ص: 381
(44) طبيعة البحث اللغوي الأصولي في فكر السيد محمد تقي الحكيم. الشيخ محسن الأراكي بحث ضمن كتاب: السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف : 155.
(45) آلية البحث عن الوظيفة العقلية في منظور السيد محمد تقي الحكيم. السيد محمد صادق السيد محمد رضا الخرسان بحث ضمن بحوث كتاب مدرسة النجف الأشرف ودورها في إثراء المعارف الإسلامية : 25.
(46) تطور الدرس الأصولي في مدرسة النجف الأشرف. سابق: 139- 140.
(47) الأصول العامة للفقه المقارن : 38
(48) المصدر السابق : 38
(49) تطور الدرس الأصولي في مدرسة النجف الأشرف. سابق : 140
(50) آلية البحث عن الوظيفة العقلية في منظور السيد محمد تقي الحكيم. سابق : 29
(51) المصدر السابق: 30.
ص: 382
ص: 383
ص: 384
نظرا لأهمية الحوزة العلمية وإدراكا لدورها البناء الرائد في المجتمع العراقي والإسلامي بل والعالمي ووعيا لثقل أعبائها على صعيدي الفكر والممارسة وتأكيدا لفاعليتها في النهوض الفكري والاجتماعي بالأمة وتوجيهها الوجهة السليمة وتسهيلا لمهمتها في البحث عن آليات وأنساق فكرية أكثر نفعا في توصيل الأحكام والآداب الشرعية وتاريخ الإسلام ونبيه وأهل بيته الأطهار والعقيدة الحقة وغيرها من أمور الشريعة الأخرى، ونتيجة لفعل العقل الشيعي المنفتح على التيارات الفكرية كلها قراءة وتحليلا ونقدا ما أدى إلى استيعاب وهضم وإعادة تشذيب وتطويع وانتاج او إعادة تشكيل الآليات الأكثر نفعا في تحقيق الغرض الأسمى، ولأن تنوع تراث ولغات وحضارات وعادات وتقاليد ومنظومات فكر وقيم طلاب الحوزة العلمية المتوافدين من دول قارات شتى من شرق الأرض وغربها يصنع ويكوِّن فضاءا معرفيا غنيا باختلافه المثمر وهو ما شكّل بمجموعه أرضية مهيئة لإصلاح الأنساق المعرفية للتعليم الديني في حوزة النجف الأشرف العلمية.
لذلك كله ولغيره فقد نشطت محاولات عديدة للإصلاح قام بها مصلحون عديدون وتبنتها حركات إصلاحية عديدة ذات منطلقات مختلفة عانت من أجلها ما عانت من صعوبات ومشاق نتيجة سيطرة الأنماط المتوارثة والأعراف السائدة والآليات التقليدية في الحوزة العلمية شأنها شأن المشاق التي تعترض سبيل المصلحين حتى يثبت التجديد جدواه العملية وثماره المرجوة.
ولقد عانى ماعانى دعاة الاصلاح في الحوزة العلمية في النجف الأشرف من
ص: 385
مصاعب وعقبات وكابدوا ما كابدوا من مشاق ومحن في سبيل تحقيق ما آمنوا به وبذلوا الغالي والنفيس من أجله تطبيقه.
ومن الطريف حقا أن نجد من حرص على بذل الوقت والجهد أولاً بأول لتدوين بعض من تلك المعاناة الشديدة التي كابدها أولئك المصلحون الأوائل فثبتها في مذكراته وأشار اليها في كتاباته فقد كتب سماحة المصلح الشيخ محمد رضا المظفر (قدّس سِرُّه) في مذكراته مؤرخا لتلك الظروف الصعبة يقول : لقد سايرت بنفسي فكرة الإصلاح حتى هذه الساعة ويقصد بذلك عام 1358 ه/ 1939 م وهو عام تدوين هذه المذكرات وسأعطيكها وليدة نشأت في أحضان الاجتماعات الصامتة ومرت عليها أدوار وتجارب غذتها حتى اشتد ساعدها ونمت نموا يناسبها شأن الكائنات الحية ولعلها الآن في دور الشباب اليافع المتحفز يحتاج إلى غذاء كثير من الجهود الجبارة والتضحية النادرة حتى يكمل رجلا سويا.
ويضيف سماحة الشيخ محمد رضا المظفر قائلاً :(1) تألفت ابتداء من 1343 ه/ 1925م أي قبل 15 عاما عن تاريخ تدوين مذكرات الشيخ (قدّس سِرُّه) عدة جماعات أشبه بجمعيات سرية أو مجالس تمهيدية للتفكير في طريق الاصلاح واكتساب الشعور العام. وأتذكر جيدا أني اشتركت في إحداها وكنت كاتبها وأعضاؤها كلهم من الشباب الديني ذلك اليوم، وجماعات أخرى هناك منها التي اتصلنا بها وهم أكبر منا طبقة أشترك أكثرهم بعد ذلك في منتدى النشر، ولا أزال أحتفظ بمحاضر جلسات جماعتي الأولى تلك وبمذكراتي الخاصة عنها وعن غيرها وهي على بساطتها تمثل لي مقدار التكتم والخوف الذي كان يساورنا وكان عملنا وتفكيرنا مقتصرا على تفقد المفكرين من أصحابنا الذين يحسون بالداء مثلنا، وبالرغم من مواصلة الجلسات والتفكير طيلة عام واحد لم نستطع أن نخرج صوتنا من غرفتنا إلا بعض الشيء ولم نسطع ان نضم الينا
ص: 386
أكثر من عشرة أعضاء فرق الزمن بين أكثريتهم في بلاد نائية وقريبة.
وقد أجمل سماحة الشهيد السيد محمد باقر الحكيم (قدّس سِرُّه) محاولات الإصلاح هذه من الناحية الواقعية في فرضيات أربع هي:
الأولى : الحركة الإصلاحية في الحوزة العلمية التي كانت تريد للحوزة ومؤسساتها أن تتحول إلى تبني هموم الأمة وقضاياها المصيرية من خلال تعبئة الأمة روحيا وسياسيا والاهتمام بقضايا العالم الإسلامي والمحافظة على الوعي الديني والالتزام العقائدي والسلوكي في أوساط الأمة والمطالبة بالحقوق السياسية والمدنية وتطوير مناهج التربية والتزكية والتعليم والتثقيف العام والمحافظة على العلاقة الروحية والمعنوية والعلمية بين الحوزة ومؤسساتها الدينية والجامعات، ويمكن أن نجد شاهدا ومصداقا لهذه الفرضية، في الحركة الإصلاحية التي قادها علماء النجف الأشرف في ثورة العشرين للحصول على الاستقلال، وكذلك نجد شاهدا في الحركة الإصلاحية التغييرية التي قادها الإمام الحكيم.
الثانية : هي الالتزام في اتجاه الإصلاح بالحوزة العلمية ومؤسساتها من أجل تحقيق الإصلاح فيها، ومن خلال تجميع المفردات المتعددة يمكن أن يتحقق تحول كبير في المجتمع من خلال عدة عناوين ومفردات من أمثال إصلاح مناهج الدراسة في الحوزة، وتنظيم الدروس وإجراء الامتحانات ووضع الضوابط للمراحل الدراسية وتنظيم الموارد المالية وتطويرها والعمل على ضمان مالي كاف للطلبة وتطوير وتسهيل الكتب المقررة وتطوير المنبر الحسيني وتنزيه الشعائر والارتقاء بها من حيث الأداء والمضمون والانفتاح على العلماء والمثقفين في أوساط المذاهب الإسلامية المختلفة وتأسيس المكتبات العامة ودور النشر والتحقيق وتعمير العتبات المقدسة وتنظيمها وبناء المساجد والحسينيات وتنشيط حركة التبليغ الإسلامي والتصدي لتفنيد عقائد الفئات الضالة في
ص: 387
الأمة كالبهائية والوهابية والخوارج والغلاة.
الثالثة : هي الالتزام بالمنهج الشمولي الكلي في الإصلاح ولكن من خارج الحوزة العلمية وإن كان يقودها رجال من الحوزة العلمية، وقد ركزت هذه الحركة جهودها على إصلاح الأوضاع السياسية واهتمت اهتماما خاصا بتعبئة الأمة سياسيا وبقضايا العالم الإسلامي الكبرى كقضية فلسطين والغزو الثقافي الغربي وبتوثيق العلاقات بين أبناء الأمة سنة وشيعة وتنشيط الوعي الإسلامي بين أوساط المسلمين إضافة إلى المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية، ولعل من أبرز الشواهد لمصاديق هذه النظرية هيجمعية النهضة الإسلامية في النجف الأشرف التي تصدت للنضال أثناء حركة الاستقلال ضد الاستعمار الإنكليزي للعراق وتنسب اليها قيادة ثورة النجف الأشرف الأولى التي بدأت بقتل الحاكم الإنكليزي للنجف قبل ثورة العشرين.
الرابعة: هي التركيز على مفردات المشاكل ومصاديق الإصلاح ومحاولة حل المشاكل ومعالجة الفساد ولكن من خلال المؤسسات في خارج الحوزة العلمية وأجهزتها كما كان يقودها في أكثر الأحيان رجال من الحوزة العلمية ومن المرتبطين بمؤسساتها وأجهزتها حيث ركزت حركتها الإصلاحية على إيلاء التربية والتعليم وتطوير المناهج والكتب الدراسية في الحوزة العلمية وإحياء التراث الإسلامي من خلال النشر والتأليف والتحقيق وتيسير عرض مباديء الإسلام للناس وحمل مهمة الدفاع عنه ونشره ورعاية الفقراء والضعفاء ومن مصاديقها.(1)
ولقد كان لكل مخطط من مخططات الإصلاح المتقدمة مصاديقه ونماذجه النظرية والتطبيقية المتعددة وهي كثيرة وبعضها ما لا يدخل في صميم البحث لذا فسأتناول أبرزها مما يدخل في موضوع بحثي هذا وذلك في الفصول التالية.
ص: 388
(1) مذكرات سماحة الشيخ محمد رضا المظفرت المخطوطة نقلا عن كتاب: الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. سابق : 94 95.
(2) ينظر العلامة الحكيم وحركة الاصلاح في الحوزة العلمية في النجف. السيد محمد باقر الحكيم. بحث منشور ضمن كتاب السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف : 51 58 ( باختصار).
ص: 389
ص: 390
ويتضمن مبحثين هما:
المبحث الأول : مشروع نظام لمدرسة كاشف الغطاء العلمية للمرجع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه).
المبحث الثاني: مشروع نظام لمدرسة دار العلم للمرجع الأعلى السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه).
ص: 391
ص: 392
وضع سماحة المرجع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء مشروعه لإصلاح نظام الحوزة العلمية في النجف الأشرف وطبقه جزئيا في مدرسته العلمية المسماة باسمه سنة 1349 ه الموافق لعام 1931م.
ولقد كان من البنود الإصلاحية التي تمنّى تطبيقها في مدرسته والمدارس الأخرى واستطاع تطبيق بعضها :
1. وضع منهاج عام للدروس والكتب التي يفترض درسها وتعليمها في المدرسة، وبذلك لم تكن الحرية للطالب في أن يختار أو يحدد نوع المادة أو الكتاب إلّا من خلال المنهج العام كما هو متبع في الدراسات الأكاديمية.
2. تقسيم التعليم على وفق ثلاث مراحل:
أ- الأولي: يتلقى فيه بعض علوم المقدمات ومبادئها.
ب- الثانوي : يكمل به اللازم من علوم المقدمات مع قسم من دروس العلوم التي يراد التخصص بها.
ج - العالي للاختصاص المطلوب الذي تتوافق فيه مواهب الطالب ورغبته.
ص: 393
كما قام بتحديد الأوقات لكل قسم ولكل علم، ولكل درس بتحديد ما لكل قسم وعلم من السنين، وما يدرس من الساعات في اليوم والأسبوع والشهر.
3. اختيار الاساتذة الأكفاء وتعيين كل منهم لتدريس العلم الذي يتميز به والكتاب من الكتب المقررة الذي يقوم على شرح غوامضه، ويحسن تقريب مسائله إلى ذهن الطالب.
4. إعداد لجان خاصة لامتحان الطالب في أوقات معينة وفي رأس كل سنة.
5. تبديل الكتب الدراسية وتعديلها بتصحيح الأخطاء أو حذف الزوائد وإتمام النواقص وتوضيح المغلق وتقويم المعوج وترتيب المشوش، ثم تقسيمها على حسب عقلية التلامذة، وبحسب مراتبهم العلمية لتتفتح بذلك السبل أمام الطالب وتقرّب النتائج وتوفر عليه من الوقت والنفقة ما يزيد من نشاطه وطموحه إلى أن يتثقف ثقافة عالية.
6. إعداد بيان ضاف في رأس كل سنة دراسية للداخل على صندوق المدرسة من الواردات والأموال على تفصيل مصادرها وطرق استيرادها بوضوح، يليه بيان للخارج من النفقات وطرق إنفاقها والتصرف بها.
7. الاقتصار على قبول الطلاب الممتازين بحسن سلوكهم وسموّ فطرتهم واحترامهم لواجبهم العلمي والثقافي من بحث ودرس وتمحيص وتدوين ليكونوا أنموذجا يحتذى وعنوانا صالحا للتطور في التدريس، مما يجعل للمدرسة سيرتها الحسنة بين الناس وأثرها الطيب في الأوساط العلمية والإسلامية.
8. فتح قاعة للمطالعة واختيار كتب خاصة مساعدة من كل علم من العلوم التي
ص: 394
لم تدرس لإطلاع الطلاب عليها.
9. تأسيس ندوة للخطابات والمحاضرات العلمية والأدبية في كل أسبوع أو في كل شهر، يتبارى بها الأساتذة والطلاب اللامعون في المدرسة ويدعى لها قادة الفكر من العلماء والأدباء والفلاسفة الذين يؤمون العراق والنجف، لما في ذلك من تنوير للأفكار والإشراف بها على مختلف المناحي العلمية والأدبية.
10. إنشاء مجلة لتحرير الأفكار العلمية والدينية وتعميم ما يقرّه منطق العلم والدين والحياة الحرة ويفرض الإخلاص والتجرد لمحض الخير والمثل الإسلامية.
11. تبادل الزيارات والبعثات العلمية بين مدرستي النجف والأزهر تمهيدا لتوحيد مناهج التعليم وأساليب التدريس في كلتا المدرستين وتأليفا بين الأذواق والأفكار والاتجاهات من كلتا الطائفتين.
12. تعديل مناهج التعليم القديم بإدخال بعض الدروس والعلوم التي يضطر الطالب بحكم مهامه المستقبلية إلى الإلمام بمسائلها وقواعدها العامة ليتثقف بثقافة عالية كعلم النفس والاجتماع والأخلاق والحساب وعلم الجغرافيا والتاريخ بما فيه الأديان والمذاهب وتاريخ الإسلام وتاريخ آداب اللغة العربية.
وقد عمل الشيخ كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه) على تنفيذ تلك البنود في مدرسته إذ تم تأهيلها بكل ما تسمح به ظروف النجف وظروفه الخاصة، وتبرع لها بمكتبته الكبرى التي تشمل على أندر المخطوطات وأنفس الكتب العلمية والأدبية(1).
ص: 395
ص: 396
يمكن النظر بأهمية استثنائية إلى مشروع لتطوير نظام الحوزة العلمية سعى للبحث في إنشائه المرجع الأعلى سماحة السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) ولكنه لأسباب شتى لم ير النور.
يقول الشيخ محسن الأراكي رئيس جمعية علماء المسلمين في أوربا يومها في خطبة ألقاها في تأبين سماحة السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) بلندن ما نصه : أتذكر وبصحبة الشهيد الشيخ حسين معن في مطلع السبعينات تشرفنا في خدمته السيد محمد تقي الحكيم، وكنا نقترح عليه آنذاك أن يبدأ بحثا على مستوى الخارج. فتداولنا معه حديث تطوير المناهج الدراسية في الحوزة فحكى لنا قضية بينه وبين سماحة السيد الإمام الخوئي (رضوان اللّه عليه) قال: بعث اليَّ سماحة الإمام الخوئي الشيخ كاظم شمشاد، فجاء الشيخ وأخبرني أن سماحة الإمام الخوئي يريد أن يلقاك أي يزورك في بيتك لمهمة يريد أن يتداول بها معك. قلت للشيخ: أنا أتشرف بخدمة السيد، فالسيد أستاذنا، وإذا يأمرني أود أن أحضر في خدمته متى ما شاء وأين شاء. فردّ الشيخ شمشاد أن السيد يريد أن يراك في بيتك
يقول السيد محمد تقي الحكيم : وجاء السيد الخوئي وجلس في زاوية في هذه الغرفة، واشار إلى زاوية معينة، ثم بدأ السيد الخوئي (رضوان اللّه عليه) يطرح مشروع تطوير الحوزة العلمية بما مختصره: إني أنوي تجديد المنهج الدراسي، وذلك بأن أكلف مائة من
ص: 397
كبار علماء الحوزة وتلاميذي الذين أثق بهم وأعتمد على قدراتهم العلمية فيتخصص كل عشرة من هؤلاء بنوع من فروع العلوم الإسلامية، وكان قد قسَّم العلوم الإسلامية إلى عشرة فروع، عشرة تختص بالفقه وعشرة تختص بالأصول، وعشرة بالتفسير.. الخ، وكل واحد من هؤلاء يشرف على عشرة من خيرة الحوزة العلمية فتبدأ بألف من طلبة الحوزة العلمية يدرسون عند هؤلاء المائة. وبهذه الطريقة نبدأ بتطوير الدراسات الحوزوية والحوزات العلمية. هكذا طرح الفكرة السيد الخوئي. وقال أنا عازم على أن أبدأ هذا المشروع في هذه البناية التي بدأت بتأسيسها إلى جانب الحرم المطهر لأمير المؤمنين وتعلمون أن السيد الخوئي بدأ بتأسيس مدرسة كبرى علمية مقابل باب العمارة وكان مندفعا أن ينفذ هذه الخطة في تجديد الحوزة في هذه البناية.
وقال السيد الخوئي: أريد أن استشيرك في هذا المجال باعتبار أن لك السيد محمد تقي الحكيم خبرة طويلة.
فقال السيد محمد تقي الحكيم : أقترح أن تبدؤا هذا المشروع بخمسة من كبار تلامذتكم بدلا من مائة من التلاميذ، وأن تبدؤا بعشرين من طلابكم الأكفاء بدلا من أن تبدأوا بألف طالب. وأن تستأجروا بيتا بسيطا فيه خمس غرف بدلا من أن تنتظروا حتى تكتمل بناية هذه المؤسسة الكبرى، وإذا بدأتم بالمشروع سوف تتوسعون فيه، كل سنة يمكنكم أن تستقبلوا مزيدا من الطلبة، وأن تكلفوا مزيدا من العلماء، فإن نجح المشروع فيها ونعمت وعندما تكتمل بناية هذه المؤسسة عندئذ تكونون قد اعددتم مجموعة من الطلبة يواصلون دراستهم في هذه البناية الجديدة. وإن لم يوفق المشروع، وأصيب بالفشل لا يقال إن زعيم الحوزة العلمية أراد أن يقيم مشروعا كبيرا لتطوير الحوزة العلمية وفشل في ذلك ففي ذلك تثبيط لعزيمة كل من يخطو خطوة في هذا المشروع في المستقبل.
ص: 398
وقال السيد الخوئي سأفكر بالأمر، وذهب ولا أدري هل اقتنع بهذه الفكرة أو لا.
هذا الذي جرى بين الإمام الخوئي والسيد والذي يدل على مدى عمق تفكير السيد الحكيم (رضوان اللّه عليه) ومدى خبرته وبصيرته في الأمور(1).
ص: 399
ص: 400
(1) الحياة الفكرية في النجف الأشرف. سابق 207-209 نقلا عن بوادر الإصلاح في جامعة النجف، أو نهضة كاشف الغطاء. مجلة العرفان. لسنة 1348 ه 1939م. المجلد 29. ج 2/ 35- 36.
(2) رحيل العلامة الحكيم. الشيخ محسن الأراكي. مجلة البلاغ. العدد 13.
إيلول ديسمبر 2001 م. ص 52- 53.
ص: 401
ص: 402
يتضمن هذا الفصل مبحثين هما:
المبحث الأول : بواكير مشروع تأسيس جمعية منتدى النشر.
المبحث الثاني : البرنامج الإصلاحي لجمعية منتدى النشر بعد التأسيس.
ص: 403
ص: 404
يمكن اعتبار جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف مثالا لإحدى أبرز محاولات الإصلاح في الحوزة العلمية في النجف الأشرف التي استطاعت أن تحول مشروعها من واقع نظري مجرد إلى حالة تطبيقية خارجية رغم الجو التقليدي المعارض، فقد هدفت جمعية منتدى النشر وسعت إلى تحديث الدراسة في حوزة النجف الأشرف منطلقة من أن إصلاح النظام الحوزوي لا يمكن أن يؤتي ثماره من دون تحديث المناهج والأنماط الدراسية التقليدية السائدة. مما أثار زوبعة عنيفة من النقد و صراعا حادا بين اتجاهين كان يرى كل منهما أن وجهة نظره لها هي الأصوب.
وقد استثمر المصلحون من رجالات الحوزة العلمية الذين شكلوا فيما بعد جمعية منتدى النشر تأثر المجتمع النجفي بمختلف طبقاته من همة فكرية شرسة شنت سنة 1349 ه/ 1931م على مدينة النجف الأشرف بخاصة والعراق بعامة وتمثلت بعض فصولها في غزو كتب معادية ذات مناح خطيرة مدينتهم المقدسة مما هيأ لهم فرصة مواتية للنهوض بتأسيس مشروعهم الاصلاحي المنتظر بتأسيس جمعية للنشر والتأليف تتصدى لمحاولات الغزو الفكري الذي طرقت طوارقه ابوابهم.
ويبدو أن تأسيس جمعية تعنى بالتأليف والنشر في النجف الأشرف فكرة راودت مخيلة المصلحين قبل تأسيس جمعية منتدى النشر بسنوات عدة، يقول سماحة الشيخ محمد رضا المظفر (قدّس سِرُّه) رئيس جمعية منتدى النشر في تقديمه لكتاب (مالك الأشتر)
ص: 405
السماحة السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) مانصه : إن هاتفا في دخيلة نفسي لا أعرف مأتاه على التحقيق يهتف بي منذ عشرين عاما تقريبا إلى ضرورة تأليف مؤسسة تعنى بتوجيه حركة النشر والتأليف في النجف الأشرف، ولست أنا الوحيد أشعر بهذا الشعور فمعي جماعة غير قليلة كان همهم ذلك حتى كادوا أن يؤسسوا هذه المؤسسة قبل خمسة عشر عاما، ومرد الشعور بضرورة هذه المؤسسة إلى إدراك أن النجف بلاد علمية من قديم القرون وعاصمة للمرجعية في التقليد والجامعة الأولى لدراسة العلوم الدينية والعربية، ولها سوق رائجة للأدب العالي، وفيها في كل عصر مؤلفون وأدباء، ولها في كل فن كتب و آثار، فهي من هذه النواحي غنية لا يضارعها بلد إسلامي آخر لاسيما قبل عصر النهضة الحديثة إلّا أن الذي ينقصها ويجب الاعتراف به تنظيم نشر ما تضم كنوزها من مؤلفات قديمة وحديثة وتوجيه التأليف على هذا النحو المرغوب فيه في هذا العهد، وتشجيع المؤلفين والناشرين في عصر راجت فيه الطباعة واتسقت حركات الثقافة واتسعت دور النشر وحرمت منه بلادنا المقدسة(1). بيد أن ظروفا اجتماعية قاهرة حالت دون ذلك.
ثم عاود المصلحون الكرة ثانية محاولين استثمار ظروف جدت عساها أن تيسر لهم سبيل تحقيق فكرتهم الإصلاحية من جديد بادئين هذه المرة أولى خطواتهم التمهيدية لتأسيس مشروعهم المرتقب مشروع منتدى النشر بأن عقدوا اجتماعهم التمهيدي الأول في دار سماحة الشيخ علي ثامر أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومدرس علوم البلاغة في منتدى النشر لاحقا، ثم توالت تلك الاجتماعات في دار سيدي الجد سماحة السيد سعيد الحكيم أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف وصاحب الثقل الديني الاجتماعي المشهود وقد تمكن القائمون بالنهضة أن يشركوا معهم أشهر رجالات النجف وعلمائها ومفكريها حتى انتخبوا هيئة عاملة تتألف من سبعة أشخاص وهيئة عليا من ثلاثة مجتهدين وباقتراح هذه الهيئة العليا نهض العلامة الأكبر المرحوم
ص: 406
الشيخ محمد جواد البلاغي لتأليف تفسير مختصر للقرآن العظيم ليكون باكورة الأعمال أسماه (آلاء الرحمن) وعاجلته المنية قبل إكماله وخرج منه جزءان وطبعا فكان هذا كل نتيجة هذه الحركة.
وجاء الدور الثالث من قبل ست سنوات وهو أبعدها مدى وأعظمها أثرا وذلك حركة الكلية كما يسمونها لأنها هزت النوادي النجفية هزة عنيفة اشترك فيها الكبير والصغير والعالم والجاهل وقد بلغ الموقعون على ورقة شروط العمل المائتين هم رجال العلم في النجف وأهل الكلمة فيه ولكن يظهر أن هذه الكثرة في ابتداء العمل وقبل انتظامه مما ساعد على توقف الحركة فلم تصمد أمام العاصفة الهوجاء(1).
ويلقي الشيخ المظفر مزيدا من الضوء على الظروف التي أحاطت بتعثر تلك المحاولة لتأسيس جمعية منتدى النشر فيقول في تقديمه لكتاب (حقائق التأويل في متشابه التنزيل) للسيد الشريف الرضي المتوفى عام 406 ه/ 1016م وهو أول كتاب حققته جمعية منتدى النشر بعد تأسيسها الرسمي ما نصه: وكادت قبل ست سنوات أن تقهر بعض الأزمات الاجتماعية هنا فتطلع للملأ حاملة راية النصر آخذة بأعضاد ثقافتنا المبعثرة هنا وهناك لولا تباطؤ في بعض مفكريها والعاملين لتحقيقها فتراجعت مهضومة ورقدت مأسوفا عليها شأن الآراء التي لا تأخذ نصيبها الكافي من النضج، ولا بدّ من الاعتراف بأن (منتدى النشر) هو وليد تلك الفكرة ونتيجة طبيعية لتلك الحركة بعد أن مضغتها النوادي النجفية بأشداقها مدة من الزمن ما زادها نضجا وأعدها للهضم، فانتهز فرصتها زمرة من الروحيين وقد عرفوا من أين تؤكل الكتف وما هي إلاّ خاطرة تحولت في يومها إلى عقيدة فعزيمة فعمل وضع موضع التنفيذ استنادا على إذن وزارة الداخلية الجليلة بتأسيسه، حتى كان منتدى النشر فكان معقد الآمال وفيه الهدف الذي صوبت له سهام تلكم الأفكار(2). وهكذا كان ففي الرابع من شوال من عام 1353ه
ص: 407
المصادف ليوم 10 / 1 / 1935م قدَّم ثلة من الشباب الروحانيين بيانا إلى وزارة الداخلية يطلبون فيه تأسيس جمعية دينية بالنجف الأشرف باسم منتدى النشر مصحوبا بالنظام الأساسي، وبعد اللتيا والتي أجازت الوزارة فتح المنتدى فتسلموا الإذن بإجازتها رسميا في: 13 / 2 / 1354ه المصادف ليوم : 15 / 5 / 1935م(1) بموجب كتاب وزارة الداخلية المرقم 9077 والمؤرخ 5 صفر 1354 المصادف 8 مايس 1935م(2).
ص: 408
ما أن تسلمت جمعية منتدى النشر الإذن بإجازتها حتى نشط أعضاؤها نشاطا ملحوظا للقيام بدورهم في الإصلاح والتنوير والتربية والتوجيه ونصرة الحق والتقريب بين المذاهب الإسلامية وغير ذلك من المهام والتكاليف الأخرى التي حفل بها برنامجهم الاصلاحي حيث تجلت أهم محاوره في الآتي:
1. النشر والتأليف
2. إصلاح نظام الدراسة الحوزوية من خلال التنظيم.
3. إعادة كتابة بعض من مناهج الدراسة الحوزوية وفق قواعد و أصول كتابة الكتب الدراسية.
4. إضافة مواد دراسية لمنهج الطالب الحوزوي تعد من صلب اختصاصه والتأليف فيها.
5. إضافة مواد دراسية لتسليح الطالب الحوزوي بمستجدات علوم عصره وإعداده لما يتناسب وثقافة الجيل المعاصر.
6. تربية جيل مؤمن يجمع بين الدراسة الأولية والثقافة الإسلامية الحقة من خلال فتح مدارس التربية الحقة والتعليم المنظم.
ص: 409
7. إعداد باحثين وكتاب ومحاضرين متمرسين أو تطوير مهاراتهم كي يكونوا مؤهلين للنهوض بواجباتهم الدينية والتبليغية.
8. إصلاح المنبر الحسيني.
9. التقريب بين المذاهب الإسلامية.
10. مد الجسور بين أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف والجامعات ومراكز البحوث الأكاديمية عراقية وغير عراقية.
11. مناصرة قضايا الشعب العراقي الحقة ومنها المطالبة بحقوق شيعة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) المظلومين المضطهدين المهمشين.
12. مناصرة القضايا العربية والإسلامية الحقة.
13. الحفاظ على اللغة العربية والوقوف ضد الحملات المعادية للغة القرآن الكريم وتنشيط الحركة الأدبية والثقافية.
14. مد الجسور بين أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف والمجامع العلمية العربية.
- ولتحقيق المحور الأول الخاص بالنشر والتأليف فقد عمدت جمعية منتدى النشر منذ اجتماعها الأول إلى حث الخطى من أجل تحقيق ونشر كتاب من تراث الآباء جامعا بين فضيلتي العلم والأدب وخدمتي الدين ولغة الضاد ليفتتح به المنتدى أعماله، وإذا بدرة يتيمة أحتفظ بها الدهر وثمالة من تراث مجيد طوّح به الزمن، فصمم مجلس الإدارة تصميم الولهان بعد فحصه الفحص الكافي على نشره بقراره الأخير في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 ربيع الثاني 1354 ه/ 1935م ثم وجّه إلى الهيئة المشرفة بعد تأليفها من
ص: 410
خيرة العلماء والأساتذة: الشيخ عبد الحسين الحلي والشيخ مرتضى آل ياسين والشيخ محمد حسين المظفر، وهم بدورهم فحصوا، حتى صدقوا قرار الإدارة بتأريخ 19 رجب 1354ه/ 1935م(1).
وهكذا بدأت جمعية منتدى النشر سنة 1355 ه / 1936م تحقيق ونشر الجزء الخامس من كتاب (حقائق التأويل في متشابه التنزيل) المتقدم ذكره لمؤلفه العالم والشاعر الكبير السيد الشريف الرضي المتوفى عام 406 ه/ 1015م، وهو الجزء الوحيد الذي تم العثور عليه لليوم من هذا الكتاب الكبير، وأخشى أن يكون الجزء المتبقي من أجزائه الكثيرة المفقودة.
و (حقائق التأويل في متشابه التنزيل) كتاب وصفه المؤرخون بأنه من أهم كتب تفاسير كتاب اللّه عز وجل المعنية بمعاني القرآن وبمتشابهه، بل قال عنه المحقق النحوي المعروف ابن جني أستاذ الشريف الرضي بعد أن اطلع على نسخته قولته المهمة كما ذكر ابن خلكان في تاريخه حين ترجم مؤلف الكتاب والتي نصها: صنَّف الرضي كتابا في معاني القرآن الكريم يتعذر وجود مثله دل على توسعه في علم النحو واللغة.
وقد طبعت جمعية منتدى النشر هذا السفر المهم سنة 1355 ه/ 1936م بمقدمة بحثية تفصيلية ضافية عن الكاتب والكتاب استغرقت 92 صفحة من القطع الوزيري ابتداء من صفحة (11220) بقلم المحقق الأديب العالم الشيخ عبد الحسين الحلي (قدّس سِرُّه).
ثم توالت نشرياتها فكانت (دروس منتدى النشر) في النحو بقلم السيد محمد علي الحكيم وقد طبعت (سنة 1356 ه/ 1937م) وفي البلاغة بقلم الشيخ علي ثامر وفي المنطق بقلم الشيخ محمد رضا المظفر و(منتدى النشر أعماله وآماله) وطبع (سنة 1363 ه/ 1944م) وكذلك (الشيعة والإمامة) بقلم الشيخ محمد حسين
ص: 411
المظفر سنة 1365 ه/ 1946م و (مالك الأشتر ) بقلم السيد محمد تقي الحكيم (سنة 1365 ه/ 1946م) و(الصادق) بقلم الشيخ محمد حسين المظفر (سنة 1365 ه1949م) كذلك و (أسبوع الإمام) مجموعة محاضرات وقصائد في الإمام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) (سنة 1365 ه/ 1946م) أيضا و (المنطق) بقلم الشيخ محمد رضا المظفر (سنة 1367 / 1948م) و (الثقلان) بقلم الشيخ محمد حسين المظفر (سنة 1367 ه / 1948م) و (السقيفة) بقلم الشيخ محمد رضا المظفر (سنة 1368 ه/ 1949م) و(الزهراء) بقلم السيد محمد جمال الهاشمي (سنة 1369 ه/ 1950م) و (شاعر العقيدة) بقلم السيد محمد تقي الحكيم ( سنة 1369 ه/ 1950م) أيضا ومجلتها المدرسية (البذرة) التي يحررها طلابها، وقد صدرت ابتداء من (سنة 1367 ه / 1948م) حيث صدر منها سنتان وسنتها تسعة أعداد.
كما عمدت في نطاق الشوط الأخير من عمر الجمعية إلى تكليف لفيف من أعضاء الجمعية وأساتذة الكلية وخريجيها للقيام بتحقيق بعض الكتب التراثية في الفقه واللغة والنحو والعقيدة بحيث استطاعت عبر سنتين أن تقوم بنشر تقوم بنشر العديد من هذه الكتب المحققة بشكل واسع(1). من أمثال كتاب (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد) لمؤسسة حوزة النجف الأشرف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (قدّس سِرُّه) وقد قامت بتحقيقه لجنة خاصة شكلها المنتدى لهذا الغرض بذلت جهدا مشكورا في تحقيقه وإخراجه وقد تم طبع الكتاب ليرى النور في (سنة 1399 / 1979م)
كما تولى المنتدى أيضا خلال الفترة المتقدم ذكرها نشر كتاب (القواعد والفوائد) للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي بتحقيق سماحة الشهيد الدكتور السيد عبد الهادي السيد محسن الحكيم وقد طبع الكتاب بجزئيه (سنة 1400 ه / 1980م) وغيرهما.
إضافة إلى ما كتبه ونشره وحققه جمع كبير من أساتذتها وطلابها وخريجيها سواء
ص: 412
من واصل منهم دراسته العليا فحاز على الشهادة العالية ببحث علمي أصيل إضافة إلى تأليفه الأخرى أم غيرهم من الباحثين الكثير جدا من الكتب والمؤلفات.
- وفيما يتعلق بالمحور الثاني من برنامج المنتدى الاصلاحي المتعلقة بإصلاح نظام الدراسة الحوزوية من خلال التنظيم، وزيادة الفاعلية وهو الغرض الأساس من تأسيس المنتدى، وليس النشر والتأليف للنشر كما يوحي بذلك اسمها وإن كان النشر والتأليف من جملة أهداف مشروع المنتدى المهم، ولعل سبب إيلاء إصلاح نظام الدراسة الحوزوية الأهمية القصوى نابع من شعور أعضاء المنتدى بعدم قدرة نظام الحوزة القائم فعلا على تلبية متطلبات العصر الحاضر لامسين لمس اليد عدم كفاءته للنهوض بمتطلبات المستقبل ناوين فيما بعد استغلال جمعية منتدى النشر الناشئة إذا تم تأسيسها وقامت قائمتها وقوي عودها للغرض الأهم ألا وهو إصلاح الدراسة الحوزوية وهو ما صرح به رئیسها سماحة الشيخ محمد رضا المظفر في رسالة خاصة بعثها إلى الشيخ أحمد عارف الزين في لبنان يقول الشيخ محمد رضا المظفر(قدّس سِرُّه)(1) كاشفا عن نواياه الحقيقية ونوايا أعضاء مؤسسته بقوله: نحن جماعة فكرنا في هذا الاصلاح، والأبواب كانت موصدة في وجوهنا حتى رأينا أن نؤسس منتدى النشر لتحقيق هذه الغاية، وأسميناه بهذا الاسم حتى لا يلفت الأنظار الى هدفنا فيقاوم قبل أن يخطو بعض الخطوات.
وربما أولاها سواء أجاءت هذه المقاومة من المجتمع الضيق الأفق أو من الجهات الرسمية التي قد لا تمنحها الإجازة الرسمية لتزاول أهدافها الحقيقية يقول سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين(2) معللا عدم النص صراحة على أهداف المنتدى
الحقيقية بقوله إن الظروف التي كانت تعيشها النجف قبل ربع قرن كانت تفرض هذا ولأن الأهداف الأخرى لو ذكرت لكان من الممكن ألا تجاز الجمعية على الإطلاق.
أما الأهداف التي أجملتها المادة (الثالثة من نظام الجمعية ) فقد فصلها الواقع الذي
ص: 413
تعيشه الجمعية الآن، هذا الواقع الذي يتألف من مدارسها الإبتدائية والمتوسطة الدينية وكلية الفقه ومكتبتها ومجمعها الثقافي وجهود أعضائها في ميادين النشر والتأليف وتغذية الصحف الأدبية.
وقد كان استهداف الجمعية لهذه الغايات الكبرى مبنيا على فهم صادق لواقع النجف كمركز ديني إسلامي عظيم ولتطورات العصر ولهذا التناقض الحاد الذي يقوم بين ما يفرضه تطور أساليب الكفاح العقائدي وما تمارسه النجف من هذه الأساليب، وعلينا لكي نفهم كل هذا أن نقرر هذه الفقرات من تقرير السكرتير العام لجمعية منتدى النشر الأستاذ السيد محمد تقي الحكيم الذي ألقاه على الهيئة المؤسسة.
ثم يستمر الشيخ شمس الدين في حديثه ناقلا مما أشار اليه فيما تقدم قوله عن أعضاء الجمعية إنهم كانوا يرون ويتحسسون بالهوة السحيقة بين ما يراد منه (المحيط العلمي الديني في النجف) وما يستطيع تأديته، فهو أي المحيط النجفي على إخلاصه وسعة معارفه يتألف من أشتات متفرقة مختلفة منها ما هو محافظ شديد المحافظة يضم إلى محافظته التي تقتضيها الظروف الدينية انطواء يبعده عن كل ما يدور حوله من أحداث، ومنها ما هو متمرد شديد التمرد يضم إلى تمرده وكفره بالمحيط إيمانا بكل جديد كما لو كان وحيا ينزل من السماء لا يقبل الأخذ والرد. والفريق الثالث: هو الوسط بين الفريقين يرى البعد الشاسع بين الطرفين ولا يملك تقريبه فيضطره اليأس إلى أن ينطوي هو الآخر على نفسه ويقبع مكملاً من بعد الشقة. فكان لا بد من العمل على إيجاد كتلة متضامنة تأخذ على عاتقها التقريب بين وجهات النظر المختلفة جهد الإمكان أو تكون همزة الوصل بين المتباعدين لتعمل على تحقيق حاجات المحيط ليؤدي رسالته على الصورة التي يتطلبها العصر الحاضر(1).
وطبيعي أن تنتج وجهات النظر المتباينة صراعاً حاداً بين دعاة إبقاء ما كان من
ص: 414
نظام الحوزة العلمية وأساليبها وكتبها الدراسية على ما كان عليه من جهة، ودعاة التنوير والاصلاح في النظام الحوزوي من جهة أخرى حتى بلغ أشده. وكان لكل من وجهتي النظر مبرراتها وحججها ما يقربها نسبيا من الحق، فالقائلون بضرورة الإبقاء على أسلوب وكتب ومناهج الدراسة في هذا البلد كانوا يرون في طابع الحرية الذي يسود أنظمتها سواء في اختيار الطالب لأستاذه، أم في الكتاب الذي يدرسه ما ينمي ملكته ويقوّي من شخصيته العلمية وكانوا يعزون إلى هذا النظام ما عرف به طلابها من حرية فكرية في ميادين المناقشة والجدال مع قدرة على التحرر من جميع مسبقاتهم الفكرية إذا اتضح من خلال المناقشة مجافاتها للحق الذي يهدفون اليه.
وكانت أبلغ حججهم على سلامة هذه الأساليب الدراسية أن عطاء هذا النوع من الدراسة في هذه البلدة المقدسة لا يعدله عطاء في إية جامعة منظمة، وحسبه أن يكون من عطائه ما تخرج عنها من مئات المجتهدين أمثال الشيخ الأنصاري والإمام الشيرازي الكبير وغيرهم ممن وصلوا بعمق تجاربهم وصلابة إيمانهم إلى أرفع المراكز القيادية في الأمة الإسلامية.
أما الآخرون فكانوا يرون في هذا النوع من الدراسة شيئا من انعدام المسؤولية، وكثرة الإدعاء وتطويل المسافات على الطلاب، وربما قصّر في الكثير منهم شوطه على الاستمرار في مواصلة الدراسة للتعقيد السائد في بعض كتبها بالإضافة إلى ما يرون من ضرورة تطعيم معارفها بما جدّ من ثقافات ومعارف قد يكون لبعضها أكبر العلائق برسالة رجل الدين في هذا العصر(1).
وقد رأى المؤسسون من دعاة مشروع منتدى النشر الإصلاحي ممن قضى سنوات وسنوات في الحوزة العلمية طالبا ثم باحثا ثم أستاذا في معرض محاولتهم إصلاح النظام التعليمي السائد في الحوزة العلمية إلى أن المرحلة الدراسية التي تحتاج إلى إصلاح وتعليم
ص: 415
منظم هي مرحلة المقدمات والسطوح فحسب دون مرحلة البحث الخارج.
ويعلل سماحة السيد محمد تقي الحكيم(1)(قدّس سِرُّه) أحد أقطاب مشروع منتدى النشر ذلك بما ذهب اليه من احتياج الطالب في مرحلتي السطوح والمقدمات إلى تضخيم الشعور بالمسؤولية، وتوفير الوقت له بتقصير المسافة الدراسية عليه بالأخذ بقسم من المناهج الحديثة في تيسير الكتب وتبسيط مفاهيمه وتطويرها، ثم إضافة علوم أخرى إلى العلوم السائدة في هذه المرحلة اقتضتها طبيعة ما جدّ من تطورات في هذه العصور وبالأخص ما يتصل بالجوانب العقائدية ليكون الطالب الذي يجتاز مرحلته الأولى بمستوى رسالته الخالدة التي يراد له تأديتها كاملة سواء انتقل إلى المرحلة الثانية أو وقف عند حدود المرحلة الأولى.
أما المرحلة الأخرى أعني مرحلة التخصص فقد بلغت في النجف وعلى يد مراجعها العظام بفضل إيمانهم بفتح أبواب الاجتهاد المطلق أقصى ما يمكن أن تبلغه دراسة واعية معمقة، ومن واجب النجف في رأيهم أن تحافظ على هذا المستوى أسلوبا وفكرا ومضامين إذا أرادت لنفسها الاضطلاع بثقل المسؤولية القيادية لهذه الأمة وعلى أساس هذه الدراسة الموضوعية لطبيعة الصراع قامت فكرة هؤلاء في تأسيس مدارس منتدى النشر بمراحلها المختلفة لتأخذ على عاتقها دور الإعداد والتهيؤ لحضور المرحلة الثانية من قبل طلابها وهم مزودون بعلوم ومعارف تلائم ما يحتاج اليه رجل الدين في هذا الصعيد. ثم بدأوا فخططوا لهذه الفكرة ورسموا لها مراحل نموّها وفضّلوا وهم وسط ذلك الصراع العاطفي أن يبدأوها صغيرة شأن كل مولود سوي ثم يمدونها بكل ما يملكون من تجارب وحكمة لتنموا نموا طبيعيا يأخذ واقعه ومكانته من الحياة.
وتأسيسا على ذلك فقد عمدت جمعية منتدى النشر في سنة 1355ه/ 1936م بعد حصولها ضمنا على ما بدا أنه عدم ممانعة جدية من المجتمع المتمسك بآليات تراثه
ص: 416
التقليدية إلى وضع خطة لتأسيس مدرسة عالية للعلوم الدينية أو كلية للاجتهاد بفتح الصف الأول الذي كان يدرس فيه أربعة علوم الفقه الاستدلالي والتفسير وعلم الأصول والفلسفة على شكل محاضرات توضع بلغة سهلة واضحة، فتبرع بتدريس الأول والثاني الشيخ عبد الحسين الحلي وتبرع بتدريس الثالث والرابع الشيخ عبد الحسين الرشتي(1). وكان الإقبال على هذا الصف من طلاب العلم منقطع النظير (2).
وتبدو سعادة سماحة الشيخ المظفر غامرة بتبرع هذين الرجلين الجليلين والعلمين الكبيرين من أعلام حوزة النجف الأشرف العلمية وأساتذتها رغم ضراوة وعنف الرفض التقليدي للدراسة المنظمة كونها خروجا عن المألوف ثم حضورهما للتدريس وإلقاء المحاضرات في حلقة دراسية منظمة ما يعد تباشير خير لنجاح فكرة الدراسة المنظمة من مشروع المنتدى الاصلاحي فقد كتب المظفر وهو يتحدث عن موضوع تبرع هذين الأستاذين الكبيرين للتدريس في المنتدى قائلا: وكان تبرع هذين العلمين بالتدريس في دراسة منظمة من أهم الأحداث في تاريخ النجف الأشرف، ويعد تضحية نادرة منهما تذكر مدى الدهر بالتقدير والاعجاب بروحهما الإصلاحية(3).
بيد أن الصف الأول من كلية الاجتهاد قد توقف بنهاية السنة الدراسية ولم يعد بفتح أبوابه ثانية في بداية السنة اللاحقة لظروف اجتماعية ضاغطة. خيبت أمل دعاة الاصلاح مؤقتا إلا أن همة القائمين على مشروع منتدى النشر الاصلاحي لم تضعف ولم تيأس وما هي إلّا شهور حتى هبت ثانية لممارسة دورها المنتظر ففي سنة (1358 ه/ 1939م) وبعد فتور مؤلم وفترة محرجة استمرت نتيجة مكابدة حادة ونكوص من البعض قرابة السنة تأسس صف لدراسة العلوم العربية والمنطق والفقه والأدب العربي وبعض الفروع الأخرى واستمر إلى آخر السنة وكان نجاحه مما شجع إدارة المنتدى أن تفتح في السنة (1357 - 1358 ه / (1938 - 1939م) الدراسية ثلاثة صفوف(4) وقد وصف
ص: 417
سماحة الشيخ محمد رضا المظفر تلك الحالة بقوله رأينا أن الوقت مناسب لفتح المدرسة وتطبيق النظام على الدراسة الدينية فنهضنا نهضة واحدة وإذا الناس معنا أكثرهم، حتى جماعة من العلماء الأعلام، فأدخلوا أولادهم، وإذا بهذه المدرسة تضم (150) طالبا دينيا في ثلاثة صفوف أكثرهم من بيوتات النجف العلمية الشهيرة(1) وهم يدرسون وفق منهجية ونظام جديد علوم العربية والمنطق والفقه والأدب العربي وبعض الفروع الأخرى في كلية منتدى النشر، آخذين كلية منتدى النشر بنظر الاعتبار قرار عمادتها العلمي تصنيف الطلاب المتخرجين من الصف السابق بعد تقييم مستواهم الدراسي طلابا للصف الثالث من الكلية، وقد اعترفت بها وزارة التربية العراقية ثم واصلت جمعية منتدى النشر برنامجها الاصلاحي فكان أن فتحت في (سنة 1364 ه / 1944م) أربعة صفوف دراسية معتبرة إياها قسما متوسطا للعلوم الدينية مع فتح صف تحضيري قبلها وثلاثة صفوف عالية اعتبرت كلية للفقه(2).
وقد قدمت جمعية منتدى النشر بعد أربع وعشرين سنة من تأسيسها طلبا رسميا بفتح كليتها (كلية للفقه) ومعه النظام إلى وزارة التربية والتعليم بتأريخ (9/22 / 1958م/1378 ه) وبعد دراسة فاحصة من قبل المسؤولين، صدقته بالاجماع وصدرت الإجازة الخطية بفتحها وفق هذا النظام بعدد 230 وتأريخ (30 /12 / 1958/ 1378ھ)(3) فخرجت هذه الكلية المئات من الطلاب وكان للعديد منهم وليس كلهم دور مشهود في القيام بواجبهم الملقى على عواتقهم سواء من تولى مهمة التدريس منهم في المدارس المتوسطة والثانوية أم من أكمل منهم دراسته العليا في الجامعات فأشرف على إعداد جيل قادم مسلح بالمعرفة الحقة أم من اتجه منهم إلى إكمال دراسته الحوزوية العالية، أم من تفرغ منهم للعمل السياسي الملتزم، أم اتجه للخطابة أم التأليف أم التعليم أم التدريس أم التبليغ وبخاصة بعد الهجرة عن الأوطان التي
ص: 418
وزعتنا نحن الطليعة بالذات من خريجي كلية الفقه ومدارس منتدى النشر الأخرى أشتاتا وعبر أصقاع متنائية من هذه الدنيا العريضة مما لم يكن بالحسبان أو يكن بالإمكان أن ترسمه لوحة من لوحات الخيال أو تعكسه صورة من صور التعبيرات الفنية.
لكني وبحمد اللّه صرت بعدها أجرأ أن أقول عن هذا التشتت أو هذه التوزيعة أنها انعکست تنويعة محمودة خلافا لما أريد أو كيد لها حتى أثمرت نتاجا آتى أكله ضعفين إن لم يكن أضعافا وشاهدي على ذلك تلك المراكز العلمية والدينية الحيوية التي احتلّها في عدد من دول العالم جمع من إخواننا المنتمين إلى مؤسسات منتدى النشر الذين صاروا حريصين على نشر الفكر والدعوة وبث الوعي الديني بين المجتمعات المنتشرة في دول مختلفة(1).
ولست أظن أن أحدا ينكر هاتيك الأقلام والألسنة في حملات التوعية ومحاولات تركيز العقيدة في النفوس من طريق المنابر الحسينية أو الحفلات أو التعليم(2).
ثم ما إن حلّ عام (1991م / 1411ه) وانتفض العراقيون الشجعان على واقعهم المرير واقع الاضطهاد والتمييز والقمع الطائفي الذي مارسه بأبشع صوره نظام الدكتاتور صدام حسين حتى كان للشعب العراقي المضطهد كلمته العليا متمثلة في انتفاضته الشعبانية المشهودة التي حررت 14 محافظة من محافظات العراق ال18، وهزت عرش الطاغية الدكتاتور هزة كادت أن تسقطه لولا وشاية بعض الدول العربية المعادية للعراق والعراقيين الشرفاء لأمريكا وحلفائها.
لقد كان من جملة المنتفضين ضد الاستبداد أساتذة وطلاب كلية الفقه حيث كان لهم حضورهم الفعلي في ساحات المنازلة. بيد أن اللّه قدر لهذه الانتفاضة الشعبانية أن تقمع ولكلية الفقه أن تغلق أسوة ببقية الكليات والجامعات في محافظات الفرات
ص: 419
الأوسط والجنوب كلها انتقاما من دور أبناء الفرات الأوسط والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ضد الطغاة غير أن ما اختلف به مصير هذه الكلية عن غيرها من جامعات وكليات الفرات الأوسط والجنوب أنها ألغيت بقرار من مجلس قيادة الثورة مع مصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة ونقل أساتذتها وطلابها وإعادة توزيعهم على الكليات المشابهة الأخرى في حين سمح لغيرها من الجامعات والكليات الأخرى في المنطقة بعد لأي بإعادة فتح أبوابها من جديد.
ومما يحسن ذكره أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد منحت هذا العام (1432 ه/ 2011م) إجازة فتح كلية الفقه الأهلية من جديد.
وليس ذلك بغريب على خريجي هذا المعهد التربوي الناشط أن يقوموا بهذا الدور المؤثر فقد أثبتت إحصائية محايدة أن الغالبية العظمى من قادة وكوادر الحركات الإسلامية العراقية على اختلاف تلاوينها هم من خريجي مدارس منتدى النشر الدينية.
كما أثبتت وثيقة أخرى أصدرتها منظمة حقوق الإنسان في العراق من مقرها في لندن مؤرخة في (1 / 5 / 2002م / 1422ه) أن بعضا من تلاميذ السيد محمد تقي الحكيم الذين انتهك النظام الصدامي المجرم حقوقهم (عدا الموجودين في داخل العراق) قد بلغ (49) طالبا منهم: (13) شهيداً و(2) ممن تعرضوا لمحاولات اغتيال و(6) من الشهداء الذين لم يعثر على قبورهم بعد و (15) قد تعرضوا للاعتقال والتعذيب و (3) هجروا بالقوة وصودرت أموالهم المنقولة وغير المنقولة و (10) طاردتهم السلطة البائدة داخل العراق وخارجه(1).
ولك أن تتصور كم سيكون العدد لو أحصينا أعداد الأشخاص المنتهكة حقوقهم من النشطاء من تلاميذ عديد أساتذتها الكثر.
ص: 420
- أما فيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بإعادة كتابة بعض من مناهج الدراسة الحوزوية كتابة جديدة تتبع الطرق الحديثة في كتابة العلوم، فقد كتب سماحة الشيخ محمد رضا المظفر كتب: (المنطق) و (أصول الفقه) و (محاضرات في الفلسفة الإسلامية) لتحل محل الكتب القديمة، وقد استطاع كتابا (المنطق) و (أصول الفقه) أن يفرضا نفسيهما بعد لأيِّ على نظام الدراسة الحوزوية في النجف الأشرف وغيرها من الحوزات العلمية الدينية الأخرى.
أما الكتاب الثالث (محاضرات في الفلسفة الإسلامية) فلم يتعد طور المحاضرات التي ألقاها على طلابه في الكلية، ولم يطبع مستقلا، ولعله لم يكتمل تأليفا ومنهجة حتى وفاة مؤلفه (قدّس سِرُّه)، وقد طبعت منه بعض بحوثه في (مجلة النجف) مجلة كلية الفقه بعد وفاة مؤلفه (قدّس سِرُّه)، وكان قبل ذلك قد ألقى على طلبة كلية منتدى النشر كتابه (عقائد الإمامية).
كما كتب سماحة المجتهد الشيخ محمد تقي الإيرواني (قدّس سِرُّه) محاضراته في علم (الفقه) ودرّسها لطلاب الصفوف المتقدمة في كلية الفقه.
وألف سماحة الشيخ عبد المهدي مطر (رَحمهُ اللّه) كتابه في النحو الذي أسماه (دروس في قواعد اللغة العربية)، ودرّسه لطلاب كلية الفقه أيضا ثم طبعه بعد ذلك مستقلا في كتاب من أربعة أجزاء.
كما درّس وكتب بمنهجية جديدة سماحة الدكتور السيد مصطفى جمال الدین (رَحمهُ اللّه)كتابه في علم العروض الذي أسماه (الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة)، وطبع في كتاب مستقل بعد ذلك.
ودرّس أيضا وكتب برؤيا بحثية متقدمة سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين (قدّس سِرُّه)كتابه في التأريخ الإسلامي الذي أسماه (محاضرات في التأريخ الإسلامي).
ص: 421
- وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بإضافة مواد دراسية لمنهج الطالب الحوزوي هي من صلب اختصاصه الدراسي ثم الكتابة والتأليف فيها إن لم يتهيأ كتاب مناسب لدراستها فقد ألف سماحة السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) كتابيه الرائدين في مجال الاختصاص: (الأصول العامة للفقه المقارن) و (القواعد العامة في الفقه المقارن)، كما ألقى محاضرات في مادة (تاريخ التشريع الإسلامي) لم يطبع منها سوى ما يتعلق ب(تاريخ التشريع الإسلامي حتى استشهاد الإمام علي)(عَلَيهِ السَّلَامُ).
كما أضيفت إلى المنهج الدراسي المقرر في حوزة النجف الأشرف أيضا مادة التفسير، و أصول التفسير، و أصول الحديث (الدراية)، والحديث، والفلسفة الإسلامية، والأدب العربي، وتاريخ الأدب(1) وعلم العروض
- وفيما يتعلق بالمحور الخامس الخاص بإضافة علوم حديثة للمنهج الدراسي في حوزة النجف الأشرف تثري ثقافة الطالب وتزيد من وعيه الحضاري وتؤهله للقيام بدوره الملقى على عاتقه في عالم اليوم، فقد عمدت كلية الفقه ومن قبلها كلية منتدى النشر إلى إضافة علوم أخرى ضمن برامجها التدريسية رفدت بها المنهج السائد في الحوزة العلمية من مثلا لفلسفة الحديثة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والتربية، و أصول التدريس، والتاريخ الحديث، وإحدى اللغات (الشرقية أو الغربية) التي يوافق عليها مجلس الكلية(2) وقد اختار مجلس الكلية من هذه اللغات اللغة الإنكليزية فقرر تدريسها فيها.
وقد قررت عمادة الكلية إضافة مادتي (قواعد الالتزام)، و(أصول الإلتزام) وهما مادتان من مواد القانون المدني لمنهج الكلية المقرر.
كما قامت جمعية منتدى النشر في وقت لاحق من عمرها بفتح دورة لتعليم (قواعد
ص: 422
و أصول علم التجويد) مثلما قامت في وقت بفتح دورات خاصة ببعض العلوم التي اعتبرتها ملحة في وقتها لطلاب حوزة النجف الأشرف كالرياضيات والمحاسبة واللغة الإنكليزية.
- وفيما يتعلق بالمحور السادس الخاص بتربية جيل مؤمن يجمع بين الدراسة الأساسية الأولية والثقافة الإسلامية الحقة، فقد نصت المادة الرابعة من نظام جمعية منتدى النشر على أن مقاصد المنتدى تعميم الثقافة الإسلامية والعلمية والاصلاح الاجتماعي بواسطة النشر والتأليف والتعليم وغير ذلك من الطرق المشروعة(1).
وتطبيقا لمحتوى هذه المادة وإدراكا من المنتدى أن أهم الأعمال التي توجه اليها تأسيس المدارس الدينية إيمانا منه بأن تربية الناشئة تربية دينية وتوجيههم إلى العلم والأخلاق الفاضلة من أفضل الواجبات المفروضة على الرجل الديني في هذا العصر وخير السبل القويمة لتحقيق أهدافه الإصلاحية في نشر الثقافة الدينية وبعث الروح الإسلامية في النفوس وتقويم الأخلاق (2) فعمدت الجمعية إلى تأسيس المدارس الدينية على اختلاف سلالمها من الابتدائية إلى كلية الفقه لتعد أجيالا مزودة بأحدث أنواع الثقافة تنبهها على ما تنطوي عليه من مفارقات أريد للغزو الفكري أن ينفذ من طريقها(3) مع مبتدئة شوطها الطويل هذا بتأسيس مدرستها الإبتدائية التي أسمتها: (مدرسة منتدى النشر الإبتدائية الدينية) سنة 1362 ه/ 1942م مضيفة إلى موادها الدراسية المقررة ما يضمن لها تنشئة جيل مؤمن متسلح بالثقافتين الدينية والدنيوية معا كي ترفد متوسطتها التي ألغيت ثم أعيد فتحها بالطلاب الحائزين على قسط ما من الدراسة الدينية الأولية ثم قدمت جمعية منتدى النشر برئاسة الشيخ المظفر اقتراحا إلى وزارة التربية والتعليم بفتح إعدادية إسلامية تعد الطالب للدراسات الإسلامية وللعلوم العربية وقامت هي بتأسيس هذا الفرع في بنايتها الخاصة واعترفت بها وزارة التربية والتعليم وباشرت
ص: 423
بمهمة التعليم في الفرع ابتداء من ( سنة 1383 ه / 1963م) مطلقة عليها اسم: (ثانوية منتدى النشر الدينية) مضيفة اليها ما يناسب مستوى الطلاب في هذه المرحلة الدراسية من مواد دراسية وثقافة دينية أساسية بما في ذلك مباديء (علم الفقه) و (مباديء علم المنطق) و(العقائد) من خلال تدريس كتاب (عقائد الإمامية) للشيخ المظفر وغيره من الكتب النافعة.
وطبيعي أن تلاقي مدارس منتدى النشر الإبتدائية والثانوية قبولا جيدا في أوساط مختلف الطبقات الدينية والاجتماعية في النجف الأشرف وغيرها ما أدى إلى فتح مزيد من مدارس مثيلة لها في أكثر من مدينة ومحافظة في العراق.
وقد دعمت المرجعية الدينية ولاسيما المرجع الشهير السيد أبو الحسن الأصفهاني والمرجع المعظم الشيخ محمد رضا آل ياسين (قدس سرهما) جمعية منتدى النشر في كليتها بإنشاء كليتها الدينية وفتح المدارس في بعض مدن العراق كالنجف الأشرف والكاظمية وغيرهما من أجل تنشئة شباب شيعي مثقف متدين يؤدي مهمته في خدمة المجتمع.(1).
وبذلك استطاعت جمعية منتدى النشر أن تخطط وتطبق على الأرض برنامجها التعليمي والتثقيفي الديني للطالب آخذة بيده منذ الصف الأول الابتدائي مرورا بالمرحلة المتوسطة والثانوية ثم الجامعية صعودا به نحو مرحلة الدراسات العليا.
- وفيما يتعلق بالمحور السابع الخاص بإعداد باحثين وكتاب ومحاضرين متمرسين أو تطوير مهاراتهم كي يكونوا مؤهلين للنهوض بواجباتهم الدينية والتبليغية وغيرها فقد أسست جمعية منتدى النشر من جملة ما أسسته لإعداد وتطوير مهارات طلاب الحوزة العلمية لجنة أسمتها (لجنة المجمع الثقافي الديني لمنتدى النشر) مفتتحة نشاطه الثقافي باحتفال كبير (سنة 1956م / 1376ه) بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
ص: 424
ومولد الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) واضعة منهجا لعملها يرتكز على:
1 - التماس كل ما في الشريعة الإسلامية المقدسة من الأسس القويمة التي وضعت لاصلاح المجتمع الإنساني من الوجهتين الروحية والمادية ولتكوين مجتمع مثالي للانسانية الكاملة ووضعها بين أيدي الناس ببزة تلائم الأذواق في عصرنا الحديث.
2 - تلافي ما حدث في حالتنا الاجتماعية الحاضرة، وذلك بأن تعرض للتفكير والتأمل لمواضع النقص فيها لتقوم بتكميلها من أقرب طريق ممكنة على ضوء تلكم الأسس المقدسة.
3 - إحياء ذكرى ابطال المسلمين ومفكريهم في مختلف العصور والبيئات واستخراج العبر من حياتهم وإرسالها إلى الناس.
4 - إيجاد التفاهم والتعاون بين رجال الاصلاح في المجتمع الإسلامي الحاضر والاستعانة بآرائهم في تحقيق ذلك الهدف القيم.
5- بعث الكتب الثقافية القديمة دينية كانت أم أدبية، وذلك بإعادة طبعها وطبع كل ما لم يطبع منها حتى الآن على أن يتم ذلك من طريق التأليف والنشر والمحاضرات(1) منيطة بلجنة المجمع الثقافي مهمة تهيئة أعضائها للتأليف وإلقاء المحاضرات النافعة و مبادلة الرأي فيما يجب العمل له في هذا السبيل فتوفقت أن تجعل يوم الجمعة من كل أسبوع يوما لاستماع محاضرات الاعضاء بصورة متوالية ثم توسعت حتى كان اجتماع يوم الجمعة يشبه أن يكون يوما عاما يشترك في الحضور فيه جماعة كبيرة غير أعضاء اللجنة من أعضاء المنتدى وغيرهم وزادت على ذلك بإقامة الحفلات والمحاضرات العامة في شتى المناسبات لفائدة العموم وقد شهدت النجف الأشرف أسبوع الإمام أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) بمناسبة ذكرى وفاته مهرجانا في مدة أسبوع كامل منقطع النظير(2).
ص: 425
ولقد كان من تقاليد المجمع الثقافي لمنتدى النشر إثارة مشاكل بيئية مستعصية وبحثها بحثا موضوعيا خالصا والتماس الطرق لعلاجها والعمل على سلوكها في حدود ما يملكه من إمكانيات(1).
وقد طلب المجمع الثقافي من سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين أن يوافيه بكتابه (النص والاجتهاد) ففاتحه بذلك من طريق الجمعية ورغب اليه لو أتحفه ببحوث من ذلك الكتاب أو بكتاب بلغه شروعه بتأليفه عن عائشة. وجاء جوابه إلى سماحة رئيس الجمعية ومعه بحثان مهمان منها وفيه عاطفة كريمة وتشجيع لنشاط المؤسسة، يقول سماحته: نصرتم الحق بما نشرتم من آياته وأقمتم من بيناته فجزاكم اللّه خير ما جزى أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ذكرتم عزم المجمع الثقافي لمنتدى النشر على إصدار سلسلة ثقافية شهرية وأنه أحب أن يفتتحها بشيء من هذا العاجز فشكر اللّه المجمع بما أولى هذا الضعيف من حسن الظن...الخ.
ورأينا بحثيه الجليلين فأكبر ناهما وأكبرنا على أنفسنا أن نفسد نظم الكتاب بتجزئته إلى سلاسل وإن تلطف سماحته فأذن بذلك، وكتبنا إلى سماحته من جديد أن يوافينا بالكتاب كاملا لنتولى شرف إصداره دفعة واحدة وفكرنا أن يكون ذلك فاتحة لسلسلة أخرى لا تتقيد بزمن وتعنى بنشر أمثاله من الكتب الكبيرة القيمة ورأينا تسميتها بدراسات إسلامية لينتظم فيها كل ما يدخل تحت هذا العنوان من الكتب ثم جاء الكتاب كاملا وتم ما أردنا لأنفسنا من توفيق بنشره(2) مع مقدمة ضافية للسيد محمد تقي الحكيم تناولت مراد المؤلف من عنونة كتابه بعنوان (النص والاجتهاد) فماذا أراد المؤلف من كلمة (النص) أولا ؟ ثم ماذا أراد من كلمة (الاجتهاد) ثانيا؟ ثم إلى ماذا تدعو المقابلة بينهما في العنوان ثالثا ؟.
وقد أجاب عن هذه الأسئلة بتفصيل ثم عكف على إلقاء ضوء على حياة المؤلف
ص: 426
وجهاده وهو ما استدعاه كتابة بحث دقيق استوعب الصفحات من : 41 إلى ص: 65.(1) من القطع الوزيري من الكتاب.
كما قررت لجنة المجمع الثقافي إعداد سلسلة مؤلفات صغيرة نافعة فيها فائدة للخاصة وتثقيف للعامة(2). وقد ظهر من هذه السلسلة كتاب الشيعة والإمامة للشيخ محمد حسين المظفر، والصادق والثقلان، وميثم التمار، وتاريخ الشيعة له أيضا، وأسبوع الإمام وهو مجموع المحاضرات والقصائد التي ألقيت في الأسبوع الذي أقامه المجمع الثقافي لمنتدى النشر في ذكرى شهادة الإمام علي 22 ( سنة 1364 ه/ 1945م) وكذلك كتاب السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر، والزهراء لسماحة السيد محمد جمال الهاشمي، وزرارة بن أعين، وأبو فراس الحمداني، ومالك الأشتر للسيد محمد تقي الحكيم، وقد تقدم ذكر المطبوع منها فيما سبق.
وما يلفت النظر بالنسبة للفترة الزمنية الملقى فيها هذا البحث الأخير توجه كاتبه في خاتمة كتابته وهو يومئذ شاب في أوائل العشرينات من عمره بكلمة ذات مغزى منطلقة من المجمع الثقافي لمنتدى النشر في النجف الأشرف إلى شباب الشرق كله جاء فيها : هذه فصول كان الدافع الأول لتدوينها هو الاستجابة لدعوة اللجنة التي أخذت على عاتقها أن تقوم بتجديد ذكرى أبطال الإسلام، والغرض من تجديدها هو إرسال سيرتهم بين الناس بما تحمل من أخلاق وقد رأت اللجنة أن مالكا كان من أعظم الشخصيات الإسلامية وأن العصر يقتضي دراسة أمثاله لتكون سيرتهم من المثل العليا للمجتمع.
وفي عقيدتي أن في دراسة أمثاله ثروة كبيرة للمجتمع الحاضر الذي يحتاج أكثر ما يحتاج إلى أمثاله من الرجال المخلصين الذين توفرت فيهم الرجال المخلصين الذين توفرت فيهم عناصر (الإيمان بالمبدأ) و(الإخلاص (له) و (التضحية في سبيله)، والشرق اليوم محتاج إلى هذه العناصر الثلاثة قبل احتياجه إلى أي شيء. وما تقدم أسلافنا من القدماء رحمهم اللّه إلّا لتوفر هذه العناصر
ص: 427
فيهم، وإلّا فنحن اليوم أقوى عدة وأكثر عددا ولا ترانا صانعين بعض ما صنعوه، إن الدين لا ينافي أي تقدم علمي او صناعي أو.. أو.. والدين ما خلق إلا لتنظيم حياتنا تنظيما ملائما للمنطق الصحيح والى تركيز عناصر الأخلاق المثالية في نفوسنا فالى الدين ياشباب والى العلم ياشباب والى الحضارة إلى الحضارة فإن الحضارة الصحيحة هي التي تجمع بين هذين(1).
ثم يتوجه جه الكاتب إلى الشباب العربي كله بمختلف بلدانه وأقطاره بقوله: أيها الشباب العربي : إن لجنة المجمع بما تضم من شيوخ وشباب حاضرة لرفع أية شبهة تختلج في خاطرك حول مبدئك، فقد آن لموكبنا أن يساير المواكب وأن يتقدمها إلى الأمام(2).
هذا وقد دعم المرجعان سماحة السيد أبو الحسن الأصفهاني وسماحة الشيخ محمد رضا آل ياسين (قدس سرهما) جمعية منتدى النشر في هذا المشروع الناهض أيضا وهو تأسيس المجمع الثقافي لمنتدى النشر حيث قام المجمع المذكور بنشاط إسلامي ثقافي نافع بإلقاء بحوث أسبوعية ونشرها بكتاب أصدرها المجمع(3).
وحين أجيزت كلية الفقه رسميا (سنة 1958م / 1378ه) جعلت من ضمن برامجها الملزمة لطلابها حضور ندوة على مدى ساعتين أسبوعيا حيث يجتمع جميع طلاب الكلية في القاعة ويتولى طالب من بين الطلبة إدارة الندوة الأسبوعية وتقدم فيها مختلف المواد والبحوث في الفقه والأصول والتاريخ والأدب والحديث والشعر وغير ذلك. ومن حق الحضور مناقشة ما يقدم والتعقيب عليه. ويحضر الأساتذة مستمعين وقد استمرت هذه الندوة على هذا المنهج مدة السنوات الأربع التي كنت فيها طالبا في كلية الفقه وكان السيد محمد تقي الحكيم يلتزم بالحضور ولا يتخلف(4).
وقد شرح مرة في بداية السنة الدراسية أهداف هذه الندوة الأسبوعية فقال بعد أن
ص: 428
اعتلى المنصة الموجودة في صدر القاعة وحيّا الطلاب وحدثنا عن كلية الفقه وأهدافها وأملها في أن يتخرج طلابها قادة ومفكرين وكتابا وأدباء وذكر أن سلاح خريج كلية الفقه هو قلمه ولسانه فهو الكاتب المنتظر والمتكلم المنتظر فلا بد أن يمرِّن قلمه على الكتابة ويتعود على الكلام المرتجل، ومن أجل هذا فإننا نطلب من كل طالب أن يعود نفسه على الوقوف أمام زملائه والتحدث في موضوع ما ويتعود على الحوار والمناقشة من خلال الندوة الأسبوعية التي تعقد كل يوم أحد في رحاب الكلية لهذا الغرض(1).
وفي مسعى آخر يصب في الاتجاه نفسه فقد عمدت مؤسسات جمعية منتدى النشر مدارس وكليات بتوجيه من أساتذتها إلى إصدار مجلات دورية شهرية لطلابها تعهد اليهم من أجل تدريبهم وتمكينهم من ممارسة دورهم المهم في الأنشطة الإعلامية المتنوعة مستقبلا مهمة إدارتها وتولي أمر تحريرها وإصدارها بإشراف منها، وتطبيقا لذلك فقد أصدر طلاب كلية منتدى النشر مجلتهم مجلة البذرة، وأصدر طلاب ثانوية منتدى النشر مجلتهم التي اسموها مجددا باسم مجلة (البذرة) استذكارا لجهود زملائهم من طلبة كلية منتدى النشر الذين تولوا اصدارها قبل سنوات، كما أصدر طلاب كلية الفقة مجلتهم التي أسموها باسم مجلة النجف. ولقد كان لي شرف الاشتراك في هيئة تحرير المجلتين الأخيرتين بعد أن انتخبني زملائي الطلاب لتولي هذه المهمة عنهم عندما كنت طالبا في ثانوية منتدى النشر ثم في كلية الفقه بعد ذلك.
ولقد كنا نحن أعضاء هيئة التحرير في مجلة (البذرة) بإشراف من أستاذ من أساتذتنا معني بشؤون البحث والتأليف هو سماحة الشيخ الدكتورعبد الهادي الفضلي حيث أناطت به الجمعية هذه المهمة، فكنا نتولى شؤون المجلة كافة من جمع المادة وتقييمها وتصنيفها إلى تبويبها إلى تحريرها إلى إعدادها إلى إخراجها إلى إرسالها للمطبعة إلى تصحيحها إلى إتمام طباعتها إلى توزيعها.
ص: 429
– أما فيما يتعلق بالمحور الثامن الخاص بتطوير المنبر الحسيني فقد أسست جمعية منتدى النشر (كلية للوعظ والإرشاد) تأخذ على عاتقها مهمة إصلاح المنبر الحسيني مما علق ببعض رواياته من شوائب وتنشئة خطباء يستطيعون النهوض بواجباتهم الملقاة على عواتقهم بما يليق بأهداف رسالة الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ولأجل هذا الغرض :، تألّفت في (سنة 1363 ه/ 1944م) لجنة برئاسة الخطيب الشهير الشيخ محمد علي قسّام وعضوية عدد من الخطباء والاصلاحيين فكان في مقدمة هؤلاء الاصلاحيين سماحة الشيخ محمد الشريعة ابن المرجع الديني (شيخ الشريعة الأصفهاني) الأستاذ والمجاهد الثائر وزعيم الثورة العراقية الكبرى بعد زعيمها ومفجرها الأول سماحة المرجع المجاهد الشيخ الشيرازي الكبير ضد الاحتلال الانكليزي، وكان في مقدمتهم من الخطباء سماحة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي عميد المنبر الحسيني وسماحة الخطيب الشهيد السيد جواد شبر وسماحة الخطيب الشيخ مسلم الجابري وغيرهم. وقد باشرت هذه اللجنة اجتماعاتها في دار سماحة الشيخ مسلم الجابري الذي تولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها، وحين استوت اللجنة على قدميها ناهضة نشطة طموحة باشرت أعمالها بفتح صف تجريبي لتدريس علم الفقه وعلم العربية وعلم الحديث أو الدراية وعلم العقيدة.
بيد أن هذا المشروع الرائد سرعان ما قبر في مهده بعد قرابة شهر واحد من فتحه نتيجة غضب أناس بسطاء حركتهم العاطفة الدينية الجياشة بعد أن سعى لإثارة غضبهم بعض الخطباء التقليدين فقامت قيامة النجف ضدها وآلت إلى تظاهرة صاخبة والتي وجد فيها بعض المغرضين فرصة للتشفي من المنتدى فهاجوا نارها بما ألقوا فيها من الحطب (1) وهو ما أدى برواد المشروع الرائد إلى أن يسرعوا بإلغائه وغلق الصف تفاديا من وقوع ما لا تحمد عقباه. ولو كان المشروع قد نجح لكنا قد حصلنا على عدد أكبر من نظراء الخطيب الشيخ أحمد الوائلي والخطيب السيد جواد شبر وغيرهما ممن أنجبتهم
ص: 430
منتدى النشر(1).
كما اضطر الرواد الأوائل تحت ضغط العنف المتأجج في النفوس البسيطة إلى ترك النجف الأشرف مؤقتا حفاظا على أرواحهم حتى تهدأ سورة الغضب فكان أن بقي خارج النجف مؤقتا سماحة الشيخ المظفر وبعض من رفاق دربه، وكان أن تركها إلى غير رجعة أصلب المدافعين عن المشروع وأكثرهم حماسة له سماحة الشيخ محمد الشريعة مهاجرا إلى كراجي بالباكستان ليواصل عمله الديني والتبليغي هناك ثم عاد الشيخ المظفر ورفاق دربه الآخرين إلى النجف الأشرف مجددا بعد هدوء العاصفة وانكشاف الغمة بعزم ثابت ليواصلوا نشاطهم الهادف الدؤوب(2).
- وفيما يتعلق بالمحور التاسع الخاص بمسعى جمعية منتدى النشر ومؤسساتها وهيئتها التدريسية للتقريب بين المذاهب الإسلامية فقد نشطت الجمعية وكليتها كلية منتدى النشر ثم كليتها اللاحقة لها كلية الفقه بأساتذتها وعمادتها وبخاصة أول عميد لكلية الفقه : سماحة الشيخ محمد رضا المظفر، وثاني عمدائها سماحة السيد محمد تقي الحكيم ومن تأثر بهما من تلامذتها الكثر حيث بذلا جهدا استثنائيا مباشرا أو دعما أكيدا، تأليفا وتدريسا وكتابة ونشراً وتحقيقا وحضورا شخصيا في مؤتمرات للتقريب مع مناقشات معمقة ولقاءات داخل العراق وخارجه للدفع بعجلة التقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة إلى الأمام.
ويذهب سماحة الشيخ محمد رضا المظفر وسماحة السيد محمد تقي الحكيم أسوة بمن سبقهما من العلماء الأعلام من أمثال سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب (المراجعات) وغيره إلى أهمية التقريب بين المذاهب الإسلامية، بل هما كما يقول السيد محمد تقي الحكيم من دعاة الوحدة ولكن لا بشكلها السلبي الذي يدعو إلى تناسي الماضي والتغافل عنه من أساسه وإسدال الستار على كل ما فيه من مفارقات
ص: 431
على نحو ما تبناها بعضهم ناسين أو متناسين أن السكوت عنها وإسدال الستار لا يذهبان برواسبها المتأصلة في النفوس وإنما تبقى تعمل عملها في داخلها إلى أن تظهر بصورة انفجار يلتمس المنفذ له في مناسبة عابرة من المناسبات، وأن جملة كبيرة من صور الخلاف بين الفريقين لا تستند على أساس، وإنما هي وليدة نسب كاذبة ودعايات خلفتها بعض الظروف وغذتها قسم من السلطات الغابرة، ولو قدر لها أن تبحث بحثا موضوعيا لأمن الفريقان بمدى بعدها عن الواقع والخلافات لا تعدو أن تكون من قبيل الخلافات بين أي مذهب ومذهب أو مجتهد ومجتهد وهي لا تستحق التنابذ والتحاقد وحتى هذه لو أمكن أن تعرض للجدل والنقاش على نحو ما صنعه العالمان في (المراجعات) لقاربت بين وجهات النظر(1).
وتأتي جهود سماحة الشيخ محمد رضا المظفر انطلاقا من نظرته التي أوضحها في كتابه المهم (عقائد الإمامية) بقوله : وإني لواثق أن فكرة التقريب بين المذاهب أصبحت حاجة ملحة وهدفا رصينا لكل مسلم غيور على الإسلام مهما كانت نزعته المذهبية ورأيه في المخلفات العقائدية، وليس شيء أفضل في التقريب من تولي أهل كل عقيدة أنفسهم دفائنها وحقائقها(2).
وتأسيسا على ذلك فقد كتب كتابه السالف الذكر (عقائد الإمامية) ليوضح عقيدة هذه الطائفة التي كثيرا ما ابتليت بالمفترين عليها من غيرها وليدرأ كثيراً من الطعون التي ألصقت ولا سيما أن بعض كتاب العصر، لا زالوا مستمرين يحملون بأقلامهم الحملات القاسية على الشيعة ومعتقداتهم جهلا أو تجاهلا بطريقة آل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) في مسالكهم الدينية وبهذا قد جمعوا إلى ظلم الحق وإشاعة الجهل بين قراء كتبهم الدعوة إلى تفريق كلمة المسلمين وإثارة الضغائن في نفوسهم والأحقاد في قلوبهم بل تأليب بعضهم على بعض ولا يجهل خبير مقدار الحاجة اليوم خاصة إلى التقريب بين جماعات
ص: 432
المسلمين المختلفة ودفن أحقادهم إن لم نستطع أن نوحد صفوفهم ونجمعهم تحت راية واحدة(1).
كما شارك سماحة الشيخ المظفر شخصيا بالحضور في المؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجه تأكيدا منه على أهمية التقريب بين المذاهب من ذلك مثلا تمثيله لجامعة النجف الأشرف في الاحتفال الذي أقامته جامعة القرويين بمدينة فاس في المملكة المغربية (سنة 1960م / 1380ه) بمناسبة مرور أحد عشر قرنا على تأسيسها وما تضمنته لقاءاته بكبار علماء المسلمين المدعوين من تجلية للمواقف وتضييق لشقة الخلاف بين مذاهب المسلمين المختلفة ولقد كان لبحثه القيم الملقى في المؤتمر والمنشور من قبل جامعة القرويين أثر بارز في ذلك. كما كان لمنهجه الفكري الواعي الذي تجلى في المساجلة التي جرت بينه وبين الباحث أحمد أمين من على صفحات مجلة الرسالة المصرية الواسعة الانتشار حول تشكيل مؤتمر يجمع بين علماء الشيعة والسنة ما يكشف عن رؤيا واقعية في تبني المنهج الأصلح للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
وقد ساهم كل من سماحة الشيخ محمد رضا المظفر وسماحة السيد محمد تقي الحكيم من خلال حضورهما الفاعل في المؤتمرات الإسلامية في تقريب وجهات النظر بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم فقد شاركا معا في المؤتمر العلمي المنعقد بمدينة كراجي الباكستانية بمناسبة مرور 14 قرنا على ولادة الإمام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ). كما شارك السيد محمد تقي الحكيم في المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة (سنة 1964م / 1383 ه) بدعوة من شيخ الجامع الأزهر الشريف.
وتكشف رسالة شخصية أرسلها السيد محمد تقي الحكيم من القاهرة إلى سماحة السيد والده (قدّس سِرُّه) يوم الإثنين (23 / 3 / 1964م / 1383ه) كيف استقبله أعضاء المؤتمر بالترحاب الشديد ناقلا حديث رئيس المؤتمر مخاطبا إياه أمام المؤتمرين بقوله:الآن
ص: 433
کمل نقص المؤتمر بكم ثم معرّفا به بأنه من علماء الشيعة في النجف، وبه اكتملت وحدة الإسلام في هذا المؤتمر حيث كان ناقصا قبل مجيئه، وكيف أنه وقف مرتجلا ليحيي المؤتمرين باسم النجف البلد الذي مرّ على تأسيس معاهده العلمية أكثر من عشرة قرون، والذي أغنى الفكر بما خرّج من المجتهدين مقارنا بينه وبين الأزهر في هذا المجال وأنه قال فيما قال مخاطبا المؤتمرين إنه يسعدني أن يرتفع باسم الشيعة الإمامية صوتي محييا هذا المؤتمر الذي نرجو أن يكون بعض عطائه القضاء على العوامل المفرقة متمنيا أن يكون في انعقاد هذا المؤتمر وأمثاله قضاء عليها من الأساس، وليبق الشيعي شيعيا والسني سنيا وخلافهما لا يتجاوز نطاق الفكر والاجتهاد وهو لا يستدعي التناحر والصراع (1).
ويبدو أثر حضوره المؤتمر ودعوته للتقارب بين المذاهب الإسلامية على أساس احتفاظ كل مذهب بخصوصيته وأن الخلاف بين المذاهب الإسلامية يجب أن لا يتعدى من الخلاف الفكري إلى التناحر بحال من الأحوال أقول يبدو أثر هذا التوجه واضحا لدى المؤتمرين فقد كتب اليه أحد كبار علماء مصر وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر سابقا سماحة الشيخ محمد محمد المدني رسالة شخصية بعد عودته من المؤتمر إلى العراق مؤرخة في 16 / 5 / 1964م/ 1383ه قال فيها: «لقد وجدت فيكم أخا وفيا كريما، وعالما قويا حكيما، وداعية إلى اللّه واعيا بصيرا جمع له بين العقل الذكي، والقلب الفتي والمنطق القوي، والوجه البهي، وإني لأسأل اللّه أن يزيدكم من فضله، وأن ينفع بكم أمتكم التي هي في أشد الحاجة إلى جهادكم وجهاد أمثالكم من العلماء المخلصين، وإني لشديد الشغف بلقاء إخواننا في النجف، فإن لأخوة العلم والدين حقوقا، وإن في لقاء الإخوان العاملين المخلصين للذة لا تعدلها لذة ولقد رأينا فيكم وفي بعض إخواننا الذين تشرفنا بلقائهم من قبل صورة كريمة تدل على العلم والإيمان والنبل فحياكم اللّه يا علماء النجف وحيا اللّه إخواننا علماء العراق جميعا من سنة وشيعة، بل مؤمنين فقط لا
ص: 434
يعرفون إلّا ربا واحدا ورسولا واحدا وكتابا واحدا وهم جميعا على سنة الأئمة المهديين العلماء العالمين وفي الختام أكرر لكم سلامي إعجابي ودعائي»(1).
كما كان لحضوره المؤتمر وللمناقشات الفكرية التي عقدت على هامشه دورها المهم في إزالة العديد من الشبهات والشكوك التي كانت تدور في أذهان المؤتمرين حول الشيعة ومعتقداتهم وبخاصة ما يتعلق منها بعصمة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وبعصمة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وكذلك ما كان تعلق منها بالشيعة والخلافة وبدعوى تحريف القرآن وغيرها، وقد طبعت هذه المناظرات في كتاب بعنوان: (التشيع في ندوات القاهرة) ونستعد الآن لطباعته طبعة ثانية بعد نفاذ الطبعة الأولى نتيجة كثرة الطلب عليه.
يقول المستشار الدمرداش زكي العقالي(2) رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس الشعب المصري سابقا في مقدمته للكتاب المذكور:
1 - إن آية اللّه السيد محمد تقي الحكيم قد قدم للمعرفة الإسلامية المقارنة بهذا الاسهام المتميز في مؤتمر البحوث الإسلامية زادا من المعرفة والتعريف بمذهب أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) باستخدام المنطق العقلي القائم على الاستدلال المستضيء بالنصوص فجمع بين رحلة العقل ووثاقة النقل مما دعا العلماء المحاورين أن يقدّروا فكره وأجوبته حق التقدير وأن يقفوا من خلال هذه الأجوبة على الأسس المكينة التي يقوم عليها مذهب أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) الذي يجمع بين احترام النص والاجتهاد.
2 - إنه بمقارنة الحجج والبينات التي استدل بها على إثبات العصمة للرسول وآله الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين ولزوم ذلك لإثبات الدين يتبين أنه قد وُفِّق إلى وضع أنوار على طريق الدراسة المقارنة بين المذاهب الإسلامية بصورة غير مسبوقة من حيث الكيف وإن سبقه في ذلك غيره من علماء الشيعة.
ص: 435
ولقد كان جهدا تأسيسيا رائدا ذاك الذي بذله سماحة السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) في تاليفه ومنهجته لكتابيه (الأصول العامة للفقه المقارن) و (القواعد العامة في الفقه المقارن)، كونها مبادرة علمية عملية منه لتأسيس منهج فكري يحتوي فيما يحتويه على أصول عامة لفقه إسلامي مقارن، وقواعد عامة في فقه إسلامي مقارن متفق عليها بين المسلمين أو مبحوثة بعمق من زوايا فكرية تقريبية حقيقية منقولة عن مصادرها الإسلامية الأصلية كي تتفرع عنها لاحقا المسائل الفقهية المتكثرة.
إن هذه المبادرة لا تكمن قيمتها في كونها لم تسبق بنظير فحسب، بل لأنها تعدّ بحق مشروعا تأسيسيا جادا يهدف إلى التقريب بصورة فعلية وعملية وليس على نحو الوعظ والدعوة الحماسية المجردة، والواقع إن هذه المحاولة التأسيسية لا تقتصر على إبعاد النهج العاطفي في معالجة أهم مسائل الفكر وأكثرها تعلقا بصميم العقيدة، بل هي تمتد إلى آفاق أوسع تتمثل بتطوير الدراسات الفقهية والأصولية المقارنة والإفادة من نتائج ذلك على أوسع نطاق لتقريب شقة الخلاف والحدّ من تأثير العوامل المثيرة للفرقة والتشاحن(1).
وحين أشار المؤلف (قدّس سِرُّه) إلى فوائد منهجه في الفقه المقارن نص في الفائدة الرابعة منها على أهميته في تقريب شقة الخلاف بين المسلمين فقال:
4 - تقريب شقة الخلاف بين المسلمين والحد من تأثير العوامل المفرقة التي كان من أهمها وأقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس وركائز البعض الآخر، مما ترك المجال مفتوحا أمام تسرب الدعوات المغرضة في تشويه مفاهيم بعضهم والتقول عليهم بما لا يؤمنون به(2).
وكانت من بعض ثمرات المنهج المتقدم المتبع في كتاب الأصول العامة للفقه
ص: 436
المقارن فيما يخص التقريب بين المذاهب ما يأتي:
1 - إنه قدّم الطريقة المثلى لكل من يتصدى لمهمة التقريب بين المذاهب الإسلامية وذلك للأسلوب العلمي الرصين والخطوات التي انطوى عليها، وأهمها إزالة الركام وإزاحة الأوهام المتعلقة في مباني كل مذهب فقهي وإظهاره على حقيقته والكشف عن مشروعيته بما يمتلكه من مستندات مشروعه وهذا يقود بالضرورة إلى احترامه وتفهمه مما يقرّب وجهات النظر.
2- الكشف عن أصالة الكثير من آراء المدارس الفقهية المختلفة وعن مدى قيمتها العلمية وبخاصة ما يتصل بفقه الإمامية الاثني عشرية هذا الفقه الذي غيّب عن الساحة وألصقت به التهم وعرض للتشكيك والتشويه دونما أثارة من علم أو مستند علمي من كتاب معتبر أو مصدر أساس. وبهذا يكون قد اسهم بدرجة كبيرة بتبديد سحب الشك والظن وألفت النظر إلى أصالة الآراء العلمية الفقهية التي تتبناها هذه المدرسة الفقهية الاصيلة، مدرسة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).
3- التنبيه إلى حقيقة مهمة جديرة بالالتفات اليها، وهي أن الفقهاء المسلمين يتفقون أكثر مما يختلفون، وأنهم ينشدون الواقع والحق إلا أن بعضهم يسلك المسلك السليم فيتعبد بالدليل، والآخر قد يخطيء الواقع وله أجر الجهد الجهيد المخلص(1).
ونظرا لموضوعية كتاب الأصول العامة وبحثه وتقييمه ونقده العلمي الهاديء البعيد عن كل ما من شأنه الإثارة أو الخروج عن الموضوعية فقد اعتمد كمنهج دراسي في كلية الفقه وفي أقسام الدراسات العليا من جامعة بغداد وفي العديد من جامعات الدول العربية والإسلامية والأجنبية في شرق الأرض وغربها.
وهناك غير هذه وتلك من مساعي التقريب بين المذاهب الإسلامية التي نهض بها
ص: 437
مشروع منتدى النشر وقام بها عمداؤه وأعضاؤه مما لا يسع المجال لذكرها هنا وربما ستأتي الإشارة لبعضها ضمن المحاور اللاحقة.
- أما فيما يتعلق بالمحور العاشر الخاص بمد الجسور بين أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف والجامعات ومراكز البحوث الأكاديمية عراقية وغير عراقية، فقد سعت جمعية منتدى النشر وكليتها كلية الفقه وأساتذتها وعمداؤها وبخاصة منهم سماحة السيد محمد تقي الحكيم الذي توجه في الستينات والسبعينات من القرن الماضي إلى فتح نافذة النجف على مراكز التعليم الأكاديمية المعاصرة فكان أول عالم شيعي مبرز في جامعة النجف الأشرف يحاضر في معهد الدراسات الإسلامية العليا في جامعة بغداد لدرجة الماجستير بعد أن عادل مجلس جامعة بغداد عام 1964م/ 1383 ه درجته العلمية بدرجة الأستاذية واستمر للتدريس فيه عدة سنوات، وهو في خطوته الجريئة هذه التي اعتبرها عملية تكاملية لمهمته الأساسية في مزج الدراسات الحوزوية والأكاديمية في الساحات العلمية وظهرت لمسات طابعه العلمي في منهجيته التجديدية في البحث والمناقشة واستخلاص الرؤية الموثقة بالأدلة والبراهين على العديد من الرسائل الجامعية لطلبة معهد الدراسات الإسلامية العليا بجامعة بغداد، وأنا واحد منهم في بحثي : : (الاجتهاد أصوله وأحكامه)، واعتبر هذا إنجازا مهما في مسيرته التطويرية في عملية التحديث الفكري التي تتطلبها ظروف العصر، وكان لذلك كله الأثر الطيب في إثارة الاهتمام لدى مجلس جامعة بغداد وتكليفه بمناقشة مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه في قسمي الدين واللغة العربية، رئيسا وعضوا في لجان المناقشة(1). فكان أول عالم ديني متشح بعمته البهية يعين بهذا المنصب في نطاق الجامعات العراقية وأول عالم ديني يستطيع أن يتخطى ذلك الحاجز النفسي الذي كان يومئذ طاغيا على مشاعر بعض الدارسين في الحقلين الحوزوي والأكاديمي(2). (ينظر الملحق الرابع والعشرون).
ص: 438
كما شارك في العديد من المؤتمرات المنعقدة في العديد من الدول العربية والإسلامية وشارك بفعالياتها العلمية والفكرية من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المؤتمر العلمي الذي دعت اليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالجامعة العربية بالقاهرة (سنة 1391ه/1971م) حول (دراسة أحرف الطباعة العربية)، والمؤتمر التأسيسي لجمعية الجامعات الإسلامية بدعوة من جامعة القرويين والمنعقد بمدينة فاس المغربية (سنة 1974م / 1394ه) وندوة معالجة تيسير النحو العربي المنعقدة بالجزائر العاصمة في الدولة الجزائرية (سنة 1975م/ 1395ه).
إن مشاركة سيدنا التقي بهذه المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية لم يكن الغرض منها في رأيه صرف مهمة الحضور الشخصي بقدر ما هو إيصال صوت جامعة النجف العلمية وإبراز طاقاتها الفكرية في العالم العربي والإسلامي. وفعلا كان لذلك الأثر الكبير في نشر فكر مدرسة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) في شتى جوانب المعرفة(1).
- أما ما يتعلق بالمحور الحادي عشر الخاص بمناصرة قضايا الشعب العراقي الحقة فقد نشطت جمعية منتدى النشر في الدفاع عن قضايا العراقيين المظلومين فكان لها ولكليتيها ولعمدائها و لأساتذتها ولأعضائها مواقف جريئة مما جرى ويجري ابتداء من مقاومة الاستعمار الغاشم على أرض العراق مرورا بمظالم النظام الملكي ثم بمآسي النظام الجمهوري وبخاصة ما تعلق منها بمجازر ومحن حكم حزب البعث الغاشم وفي مقدمتها طائفيته القاتلة، إن هذه المواقف هي ما جرّت على جمعية المنتدى وكليتها كلية الفقه الويلات التي كان آخرها إلغاء جمعية منتدى النشر ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة ومنع إصدار مطبوعاتها الثقافية الدورية ثم إلغاء كلية الفقه لاحقا لدورها في الانتفاضة الشعبانية المباركة (سنة 1411ه/ 1991م) بموجب قرار من مجلس قيادة الثورة برئاسة دكتاتور العراق السابق صدام حسين ومصادرة أموال الكلية المنقولة
ص: 439
وغير المنقولة وتوزيع طلابها وأساتذتها على كليات العراق المماثلة الأخرى كما تقدم.
ولو أردت أن اضرب لذلك مثلا، فسأضرب بموقف كلية الفقه وعميدها المظفر من قانون الأحوال الشخصية العراقي الصادر سنة 1959م/ 1379ه) فقد كان موقف علماء النجف الأشرف بعامة ومنه موقف عميد كلية الفقه الرافض لقانون الأحوال الشخصية صريحا وواضحا حيث وقع علماء النجف الأشرف ومنهم سماحة الشيخ محمد رضا المظفر (قدّس سِرُّه) على رسالة منددة بهذا القانون ومصرحة بمخالفته للقانون الإسلامي ولنصوص القرآن الكريم أرسلت إلى الجهات العراقية المسؤولة ووزعت على نطاق واسع. هذا نصها:
لقد اطلعنا على قانون الأحوال الشخصية فوجدناه يصطدم في كثير من مواده بالقانون الإسلامي المقدس وبنصوص القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فأسفنا أن يشرع مثل هذا القانون، ولا سيما في العراق البلد الذي يرجع اليه المسلمون أجمع في تعرف أحكام الإسلام الحنيف وتشريع القرآن الكريم، فكان الجدير بقانون الأحوال الشخصية أن يكون صدى لصوت القرآن ونسخة مطابقة لأصل قانون الإسلام لا يحيد عنه، فالمأمول من سيادتكم إصدار الأمر بتعديله على وجه يطابق القانون الإسلامي(1).
كما أعدت كلية الفقه دراسة تفصيلية عن بنود هذا القانون ومدى مخالفتها للأحكام الإسلامية الثابتة بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وأرسلتها إلى المعنيين بالدولة ثم نشرته بمجلة الكلية مجلة النجف ليطلع عليه الرأي العام في داخل العراق وخارجه.
إضافة إلى ما بذله سماحة الدكتور السيد محمد بحر العلوم أحد كبار خريجي كليتها كلية الفقه من جهد مثمر في كتابه الموسوم (أضواء على قانون الأحوال الشخصية)
ص: 440
مشيرا إلى موارد مخالفاته للشريعة الإسلامية الغراء.
أما ما كان يتعلق بالشق المتفرع عن هذا المحور والمتضمن مواقف جمعية منتدى النشر وكليتها وأساتذتها من المطالبة بحقوق شيعة العراق المظلومين بخاصة فهي متنوعة وعديدة يأتي في مقدمتها المواقف الرافضة للسياسات الطائفية المقيتة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة على حكم العراق خلال تاريخه الحديث وبخاصة ما عانته الأغلبية الشيعية في العراق خلال العهدين الملكي والجمهوري من اضطهاد وقتل وتشريد وتعذيب وإقصاء وما يعجز الكلام عن استيعاب تفاصيلة وخوض غمار مكابداته و مآسيه خلال القرن الماضي كله وبالأخص خلال فترة حكم البعثيين من صدام حسين وزمرته فمن مواقف جمعية منتدى النشر ممثلة بمواقف عميديها الكبيرين سماحة الشيخ محمد رضا المظفر وسماحة السيد محمد تقي الحكيم (قدس سرهما) فقد بلغ الوجع بالشيخ المظفر مداه من جراء ما ابتلي به أتباع أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) من تكفير فيقول:
على أي شرع جاز تكفير معشر***بها الشرع لم يترك مقالا لعائب
ثم يعرج على ما عانته طائفته ورجالها من محن وأرزاء مستنهضا الإمام المنتظر (عَلَيهِ السَّلَامُ) لاستعادة الحق المغتصب متخذا من ذلك غطاء للدعوة إلى الثورة ووسيلة لبيان ما لحق بالطائفة من حيف وحرمان في مختلف العهود يقول المظفر مخاطبا الإمام المنتظر (عَلَيهِ السَّلَامُ):
فقم سوم الخيل الجياد وعج بها***فإن الأماني في متون النجائب
ألا فاحتلبها من نفوس مروعة***وليس يدر الضرع من غير حالب
صواد إلى جد النزال سواغب***ألا فاستثرها من صواد سواغب
ولولاك هذا الخطب لن يستفزها***ولو ملأت رحب الفضا والسباسب
خمول وجبن وافتراق وذلة***توالت عليها بالأماني الكواذب(1)
ويبدو شجن الشيخ المظفر (قدّس سِرُّه) صارخا من جزاء سنمار الذي جازى به حكام
ص: 441
العراق مدينته المجاهدة مدينة النجف الأشرف ومركز المرجعية الدينية العليا للشيعة في العالم وهي التي أوقدت شرارة الثورة العراقية الكبرى وقادتها وعلى أكتافها تشكلت دولة العراق.
وطبيعي أن يحز ذلك الموقف الجاحد في نفسه فيلجأ إلى الشعر عسى أن يطفيء لوعة مشاعره العاتبة فيقول مخاطبا العراق عما قدمه للنجف الأشرف التي قدمت له كل غال ونفيس في الرأي والموقف والتخطيط والتنفيذ فيقول:
ياعراقي جهلت (مسقط رأسي)***وهو في الشعب كالهلال المضيّ
فبأي الحقوق جازيت أهليه***وياليت كنت تدري بأيّ
عقدوا (مجلس الحماية) عن حقك***مذكنت طعمة الأجنبيّ
يوم هبت وأنت في قبضة الغرب***رجال منهم بأنف أبي
ناضلت عنك والحسام صدي***فجلته بفكرها الثوريّ
أين علياك هذه اليوم لولا***عصبة كابدوا العنا في (الغريّ)(1)
وهو الموقف نفسه موقف الغضب من حكام العراق الجاحدين لدور النجف الأشرف هو ما عبّر عنه رفيق دربه وخلفه على عمادة كلية الفقه سماحة السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) يوم قرر الدكتور عبد الرحمن البزاز رئيس وزراء العراق (سنة 1966م / 1385ه) زيارة كلية الفقه في النجف الأشرف فاتصلت الجهات الإعلامية والأمنية بالسيد محمد تقي الحكيم عميد كلية الفقه وأخبرته أن رئيس الوزراء سيزور كلية الفقه فما هي الترتيبات والاستعدادات لاستقباله؟ فقال: نحن لم نوجه له الدعوة لزيارتنا فإن قبل بزيارتنا على ما نحن عليه فمرحبا به، وإلّا فيمكن إلغاء الزيارة. قالوا: ولو جاء من غير استعداد ولا ترتيب ولا مراسيم فبماذا ستتحدثون معه ؟.
قال لهم السيد محمد تقي الحكيم : سنجيبه عن الحديث الذي سيبدأ به، وليس لدينا
ص: 442
حديث مسبق. فلم يستفيدوا منه شيئا وانصرفوا وفي الموعد المقرر لزيارة رئيس الوزراء حضر يرافقه الدكتور عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة والوزير سلمان الصفواني واستقبلهم السيد محمد تقي الحكيم في كلية الفقه وفي مجلسه الاعتيادي وابتدا الحديث بقوله : إن النجف اليوم تلتقي بعبد الرحمن البزاز العالم وعبد الرحمن الحاكم وعبد الرحمن المحامي، وهي تقيم دعوى على عبد الرحمن البزاز الحاكم عند عبد الرحمن البزاز العالم وتوكل عبد الرحمن البزاز المحامي للدفاع عنها. فقال الدكتور عبد الرحمن البزاز: لقد ألبستني ثلاثة ثياب مرة واحدة، ولكنني في كل الأحوال لست خصما للنجف.
فقال السيد محمد تقي الحكيم: إذا كنت الدكتور عبد الرحمن البزاز الفرد فأنت قطعا لست خصما لها، ولكن إذا كنت جهة، إذا كنت رئيس وزراء الدولة فأنت خصم لها. لقد أسهمت النجف في كل الثورات التي حصلت في العراق بدءا من ثورة العشرين وأسهمت في تأسيس الدولة العراقية عام 1920م / 1338 ه فماذا جنت من ثمار !!؟(1).
ولم يكن موقف سماحة السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) من عدم الحفاوة باستقبال رئيس وزراء العراق الدكتور البزاز ولو أدى ذلك إلى إلغاء الزيارة جديدا عليه، أو جديدا على مواقف علماء النجف الأشرف فلقد كان هذا هو دأبه ودأبهم في تعامله وتعاملهم مع الحكام العراقيين الطائفيين والظالمين ومن ناكري جميل النجف الأشرف عليهم أو معاقبيها ومعاقبي أتباع أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) بدوافع طائفية وهو ما درج عليه حكام العراق الطغاة باستمرار منذ بداية القرن الماضي.
يقول الدكتور حازم الحلي مشيرا إلى ذلك عندما انعقد مؤتمر اتحاد الأدباء السابع في بغداد عام 1966م / 1385ه جعل إحدى جلساته في الكوفة وزارت الوفود كلية الفقه فاستقبلهم السيد محمد تقي الحكيم وأساتذة الكلية ورحب بهم السيد محمد تقي الحكيم بكلمة ألقاها في الحفل التكريمي الذي أقامته الكلية لهم وتجاهل تحية رئيس
ص: 443
الوزراء الذي كان معهم متعمدا لأنه كان لا يحفل بالمسؤولين ولا يحترمهم(1).
ولطالما عمل السيد عميد كلية الفقه بقناعته هذه مع رؤساء جمهوريات العراق السابقين ومع رؤساء وزرائهم ووزرائهم المنحرفين رغم أنها عرضت حياته مرات عديدة إلى الخطر ثم انتهت به أخيرا إضافة لأسباب أخرى معروفة إلى السجن ثم الإقامة الجبرية ثم الوفاة.
ولقد كان المارة في الشارع يرون بباب السيد محمد تقي الحكيم شرطي أمن وضع له أريكة واستقر عليها نهارا وينام عليها ليلا وله من يساعده في هذه المهمة واستمرت هذه الحال على مدى أربع سنوات تقريبا، وبعد أربع سنوات علمت بأن الرقابة والحراسة قد رفعتا عنه وصار بإمكانه التحرك حيث يشاء بمراقبة خفية(2).
كما كان للعديد من أساتذة كلية الفقه وأعضاء جمعية منتدى النشر وطلابها مواقف مماثلة في الدفاع عن حقوق شيعة أهل البيت المضطهدين في العراق طوال تاريخهم كما تقدم، ويشهد على تلك المواقف من عاصر تلك الفترة ووعاها، ويكفي أن نتذكر مواقف الشاعر الدكتور السيد مصطفى جمال الدين (رَحمهُ اللّه) أستاذ كلية الفقه وأحد رموزها الكبار في مقارعة النهج الطائفي للأنظمة البائدة، وهو ما ضمنه بالأرقام مذكرته المهمة التي سمعتها منه مباشرة وكان من المقرر أن يتلوها في احتفال النجف السنوي بمناسبة ميلاد الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الستينات من القرن الماضي إلّا أن الظروف حالت بينه وبين إلقائها ولم تنشر وأخشى ما أخشاه أن تكون مسودتها قد فقدت بفقده (رَحمهُ اللّه)، ثم ما فاض به دیوانه (الديوان) من قصائد كثيرة تؤكد هذه المواقف الحقة(3).
ولقد أبدع قلمه في تبيان محنة شيعة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وهم الأغلبية المطلقة من الشعب العراقي على يد ظالميهم وغاصبي حقوقهم من حكام العراق الطائفيين
ص: 444
وبخاصة زمن الدكتاتور صدام حسين وموقف اشقائنا العرب من تلك المحنة وذلك في كراسه : (محنة الأهوار والصمت العربي) الصادر (عام 1993م/ 1413ه) حيث قال: كنا نظن أن ما يؤلمنا نحن عرب العراق يؤلم إخوتنا في المصير والأهداف، فإذا بنا بعد سنين من النضال المرضد المستعمر وأدواته المحلية لا نجد من يعطف على قضيتنا العراقية، لا من الأنظمة التي تحارب الآن رأس النظام بكل جهدها وطاقاتها(1) ولا من الشعوب العربية التي شاركناها كل آلامها وآمالها. حتى لقد اصبح غريبا جدا أن نقرأ بيانا لتنظيم إسلامي أو عربي أو مقالا لكاتب أو قصيدة لشاعر، نحس منه بعض العطف على هذا الشعب المسحوق بإقدام جيشه العربي، من مِن هذه الأمة العربية تذكّر علماء المسلمين الذين قتلوا منا بالمئات أو مناضلينا الذين أعدموا بمئات الألوف، أو شعبنا الذي سحق بالدبابات والأسلحة الفتاكة حتى المحرمة دوليا، بل إن بعض زعمائنا العرب يطلب في واشنطن الابقاء على النظام العراقي(الصدامي) بحجة أن في زواله تقسيم للعراق، وهو يرى بأم عينيه أن بقاءه هو الذي قسم العراق، من مِن هذه الأمة من استنكر إهدار شعائرنا الدينية وهدم عتباتنا المقدسة ودور عبادتنا الشريفة؟ في الوقت الذي نرى فيه مسجدا صغيرا في أقاصي الهند أقام الأمة العربية وأقعدها، ومسجد الإمام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) ومرقده وهو العربي الصميم ورابع خلفاء المسلمين يقصف بالصواريخ ويسحق بالدبابات ولم أسمع في حدود علمي من هذه الأمة العربية المسلمة شعوبا وحكومات من استنكر ذلك.
وإذا حدَّثنا يا إخوتنا في العروبة بعض المغرضين المتربصين بأن السبب في هذا الصمت العربي المطبق، هو أن الدبابات التي احتلت المراقد المقدسة كانت تحمل شعار (لا شيعة بعد اليوم)، لم نجد ما نرد به کیده و نخرس به لسانه على قوة بلاغتنا العربية !!
كذَّبوا هؤلاء المغرضين ببيان،واحد بقصيدة واحدة، بخبر ينشر في تلفازاتكم
ص: 445
الناطقة مع شديد الأسف بلغة العرب، لعل هذا الخبر، أو تلك القصيدة تبدد صمتكم المتعمد عن مأساة شعب يقتل ويهجر بالملايين وتصادر أمواله وجنسياته، وتغير طبيعة سكناه، وتسحق كراماته ودينه بأحذية جنودهم مع الاعتذار من هذه الأمة العربية (1).
ويستمر المغفور له سماحة السيد جمال الدين موجها كلامه بتأنيب عاتب محقّ إلى إشقائه العرب قائلا: نحن لا نريد منكم يا إخوتنا دماء تجري في أهوار سوق الشيوخ أو أم النعاج، ولا أموالا نعيد فيها بناء عتباتنا المقدسة في النجف وكربلاء، ولا أسلحة ندافع بها عن كراماتنا المهدورة في سهول العراق وهضابه، وإن كنتم والحق يقال أنفقتم الأموال الطائلة واستوردتم الأسلحة الفتاكة، وبذلتم الدماء الغزيرة في بلد إسلامي غير عربي حتى أصبحت تقليعة (الأفغان العرب) من أطرف ما تضج به صحف الغرب والشرق.
نحن نريد فقط أن تشعرونا بأننا عرب مثلكم وان دماءنا التي تسيل في أهوار العراق وسهوله هي من نفس الشرايين التي أمدتكم بدماء قيس وتميم وأسد وعامر، لا تجعلوا من عقيدتنا في مذهب أهل البيت حائلا أو إكسيرا يحيل دماءنا العربية ماء، فنحن لم نجعل من من مذاهبكم سدّا يمنع عروقنا أن تروي عطش البيارات في القدس وبيت لحم، ولا غصة في لهات الشبيبي أو الجواهري أو عبد المحسن الكاظمي، تمنع هدير الشعر أن يتغنى بأمجاد ميسلون أو بور سعيد أو طرابلس الغرب(2).
ثم يعرج على دور مثقفي العرب الطائفي الغريب قائلا ثم لماذا هذا الجهل حتى من مثقفي العرب بتاريخ عروبتهم وجغرافيتها فتنسب مراكز دراساتهم العربية التشيع إلى القومية الفارسية !! أتجهلون، واقعا، ان التشيع عربي المولد والنشأة والامتداد، وانه ولد في المدينة، وترعرع في الكوفة، وامتدت جذوره على مساحة الدماء العربية في الأحساء والبحرين وعمان وبلاد الشام، ولم يصل هذا المدّ الشيعي إيران إلّا بعد ألف سنة من
ص: 446
انتشاره العربي. يوم كان (المزيديون) في الحلة، و(الحمدانيون في الموصل وحلب، و (الفاطميون) في مصر والمغرب، و (العلويون) في فلسطين، و(الزيديون) في اليمن، لم تكن بلاد فارس تعرف عن هذا التشيع شيئا !!.
أتظنون أن النجف وهي الامتداد الطبيعي للكوفة أخذت تشيعها عن فارس الشافعية !! وأن هضاب عامل وبعلبك منفى أبي ذرّ الغفاري أخذت حب الحسين عن أصفهان الأموية؟.
أعيدوا قراءة تاريخكم من جديد لتعلموا أن العكس هو الصحيح، ف(الخدابنديون) في فارس أخذوا تشيعهم من العلامة الحلي في العراق، و (الصفويون) في أصفهان تعلموا حب أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) من المحقق الكركي في لبنان.
أليس من سخرية القدر أن تعلمنا عروبتنا أقلام عروبتها من قوارير !!، لقد امتزج الإسلام بالعروبة امتزاج الروح بالجسد وانتشر التشيع من جزيرة العرب انتشار المذاهب الإسلامية الأخرى، فكان عدد الشيعة في الهند وباكستان أكثر من عددهم في إيران، فلماذا الاصرار على ربط المذهب الشيعي بالقومية الفارسية (1).
- أما ما يتعلق بالمحور الثاني عشر الخاص بمواقف جمعية منتدى النشر في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية الحقة فهي عديدة وسأكتفي بالإشارة إلى موقف واحد من مواقفها في تبني الدفاع عن القضايا العربية وكذا الأشارة إلى واحد من مواقفها في تبني الدفاع عن القضايا الإسلامية تاركا استعراض الأخريات وتحليل نصوصها وظروفها وتأثيراتها على الصعيدين العربي والإسلامي إلى مجال آخر ألصق بالبحث.
فمن مواقف جمعية منتدى النشر في تبني القضايا العربية الحقة والدفاع عنها موقفها المدوي والمعبر عنه في مناسبات كثيرة والمتضمن مناصرة القضية الفلسطينية في كل
ص: 447
مراحلها والدعوة إلى بذل الغالي والنفيس في سبيل مؤازرتها لتطهير القدس الشريف وغيره من براثن الغزاة المحتلين، وكذلك مناصرة المجاهدين الجزائريين فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر لتحرير أرضهم من المستعمرين، وكذا التنديد بالعدوان الثلاثي الغاشم على مصر ( عام 1956م / 1376ه) وغيرها، وقد تم التعبير عن هذه المواقف بطرق متعددة كإصدار البيانات وإرسال البرقيات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وكتابة البحوث والمقالات وإقامة الاحتفالات ونظم القصائد وإنشادها وغير ذلك كثير وقد حفلت دوريات جمعية منتدى النشر وكلية الفقه وغيرها بهذه النشاطات المناصرة.
ولأن البحث غير معني بتفصيل مواقف جمعية منتدى النشر في هذا المحور لذا فسأكتفي بذكر موقف واحد منها للتدليل على ما اقول، مستشهداً بموقف جمعية منتدى النشر من العدوان الثلاثي الغاشم على مصر، فقد أبرق سماحة الشيخ المظفر (قدّس سِرُّه) باسم عمادة كلية منتدى النشر برقية إلى شيخ الجامع الأزهر في تشرين الثاني من(سنة 1956م / 1376ه) قال فيها : محافل النجف الأشرف تعج صارخة اليه تعالى بدعائها لإنقاذ مصر المسلمة وتبتهل اليه أن يأخذ بناصركم ويرفع لواءكم والقلوب تقطر دما من الاعتداء الصارخ الذي تقوم به وحشية أعداء الإسلام والإنسانية، والمسلمون في جميع البلاد يد واحدة في شد أزركم(1).
وإذ اندلعت الاضطرابات في النجف الأشرف بعد تصدي حكومة نوري السعيد للمتظاهرين المنددين بالعدوان الثلاثي على مصر وبموقف الحكومة العراقية منه، مستعينة بالسلاح الحي وبقية أدوات القمع الأخرى، ما أدى إلى سقوط بعض المتظاهرين قتلى وجرحى، رفع جماعة من رجال منتدى النشر برقية إلى البلاط الملكي ووزير الداخلية في (24 / 10 / 1956م / 1376ه) يستنكرون فيهما الاجراءات التعسفية التي قامت بها الشرطة ضد المدنيين.(2)
ص: 448
بيد أن الأمة العربية شعوبا وحكاما نسيت في حمأة الطائفية المقيتة كيف أَنَّا شيعة العراق العرب قد حملنا قضايا أمتنا العربية بقلوبنا وأكفنا، من (طويلات العمر) كالقضية الفلسطينية المعمّرة، إلى متوسطات السن كالجزائرية والتونسية، إلى صباياها الصغار حتى (السقط) الذي لم يبلغ عمره سبعة أشهر كالقضية الكويتية، لتردّوا يا إخوتنا في العروبة دين الدماء التي ضمخت هضاب يافا وحطين، والأموال التي أنعشت جهاد جبهات التحرير في الجزائر وتونس وفلسطين، وفتاوى علمائنا الأبرار التي ساندت ظهر عمر المختار في ليبيا وعبد الكريم الخطابي في ريف المغرب(1).
أما فيما يتعلق بمواقف جمعية المنتدى من قضايا الأمة الإسلامية الحقة فهي عديدة كذلك أكتفي من استعراضها بالإشارة إلى موقفها المتمثل بدور رئيس جمعية منتدى النشر وعميد كليتها سماحة الشيخ المظفر (قدّس سِرُّه) مما كانت تعانيه الجارة المسلمة إيران أثناء حكم الشاه من أمور تتنافى مع مباديء وقيم وتعاليم الإسلام الحنيف فقد كان (قدّس سِرُّه) يجتمع مع العلماء في النجف الأشرف في بيته العامر أو في غير بيته وليدرس المشكلة دراسة معمقة ويخطط العمل ويسعى لانقاذ الموقف في إيران ومواصلة إخوانه من العلماء المجاهدين في هذا البلد الإسلامية العزيز بما يسعه من المواصلة وكان يكتب بنفسه كثيرا من النشرات التي صدرت عن النجف في هذه الفترة ويوشحها بتوقيعه الكريم فيمن يوقع من أعلام الفكر والجهاد في النجف الأشرف(2).
وفيما يتعلق بالمحور الثالث عشر الخاص بالحفاظ على اللغة العربية والوقوف ضد الحملات المعادية للغة القرآن الكريم وتنشيط الحركة الأدبية والثقافية فقد أولت جمعية منتدى النشر جل اهتمامها لهذا المحور فدأبت على إيلاء هذا الجانب أولوية في وضع مناهجها التعليمية وبرامجها التدريسية فعقدت له الندوات واللجان وأقامت له التجمعات والاحتفالات ودربت عليه الأعضاء والطلاب وأنشأت له المجلات
ص: 449
والدوريات وتحملت من أجله ما تحملت من عناء وبذلت في سبيل الإعداد له الجهد والمال والوقت فما من مناسبة دينية أو أدبية مرت إلا واستذكرتها المنتدى شعرا ونثرا وما من وفد أم النجف الأشرف إلا ودعته المنتدى أو أختها الرابطة الأدبية للاحتفاء به وإطلاعه على دور النجف الأشرف ومثوى إمام البلغاء في صيانة اللغة العربية وحفظها من محاولات العبث بها.
وليس أدل على ذلك مما جاء في المادة الثالثة من (قانون منتدى النشر) الصادر سنة 1354 ه/ 1935 م حيث نص ذيل المادة الخاص بمقاصد المنتدى على أن المنتدى يعتني عناية خاصة بإحياء اللغة العربية الفصحى(1).
وما جاء كذلك في تقدمة (نظام كلية الفقه في النجف الأشرف) الصادر عام 1958م / 1377ه من أن جمعية منتدى النشر عملت على فتح كلية للفقه لتخريج مرشدين ذوي اختصاص بالعلوم الإسلامية واللغة العربية(2) معترف بها وهو حق طبيعي لمثل النجف الأشرف البلد الذي مرّ على تأسيس جامعته الإسلامية أكثر من ألف عام تقريبا والذي زوّد العالم الإسلامي بألوف المجتهدين ومراجع التقليد ضمن تلكم العصور، وكان وما يزال حصن اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وموقفه من السياسات الإستعمارية التي حاولت القضاء على لغة القرآن وعلى ثقافته وروحه الثورية المتحررة موقف،معروف، ولولاه لما استطاعت اللغة العربية أن تعبر تلكم العصور المظلمة وهي معافاة من كل سوء(3).
ويكفي أن يستعرض المستعرض أسماء وأعداد الأدباء والكتاب والمثقفين والشعراء الذين انتسبوا أو درسوا أو درسوا أو تخرجوا من مدارس جمعية منتدى النشر أو من كليتها الأولى كلية منتدى النشر أو كليتها اللاحقة لها كلية الفقه وفي مقدمتهم شاعر العراق الكبير المرحوم السيد مصطفى جمال الدين ليعرف حجم ما أسدته جمعية
ص: 450
منتدى النشر بمدارسها كلها للغة القرآن الكريم وللنجف الأشرف في هذا العصر من فضل ويكفي الوقوف لماما على نشاطات لجنة المجمع الثقافي لمنتدى النشر التي توفقت أن تجعل يوم الجمعة من كل أسبوع يوما لاستماع محاضرات الأعضاء بصورة متوالية ثم توسعت حتى كان اجتماع يوم الجمعة يشبه أن يكون يوما عاما يشترك في الحضور فيه جماعة كبيرة من غير أعضاء اللجنة من أعضاء المنتدى وغيرهم، وزادت على ذلك بإقامة الحفلات والمحاضرات العامة في شتى المناسبات لفائدة العموم، وقد شهدت النجف في أسبوع الإمام أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) بمناسبة ذكرى وفاته مهرجانا في مدة اسبوع كامل منقطع النظير.
وقد فكرت بالأخير أن تعد مشروعا ابتدائيا كباكورة لأعمالها التي تنويها وهو إعداد سلسلة مؤلفات صغيرة نافعة فيها فائدة للخاصة وتثقيف للعامة(1).
أما فيما يتعلق بالمحور الرابع عشر وهو الأخير الخاص بمد الجسور بين أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف والمجامع العلمية واللغوية العربية. فقد شغل سماحة الشيخ محمد رضا المظفر رئيس جمعية منتدى النشر وعميد كلية الفقه عضوية المجمع العلمي العراقي منذ (سنة 1383ه / 1964م) واشترك في جلساته البحثية العميقة ومداولاته اللغوية وكان الحضوره أثر مهم في نشاطات المجمع العلمي العراقي المعرفية ودقة ملاحظاته اللغوية(2).
كما انتخب سماحة السيد محمد تقي الحكيم عميد كلية الفقه بطريقة الاقتراع السري بترشيح من علامتي العراق المرحومين الشيخ محمد رضا الشبيبي والدكتور مصطفى جواد ففاز بالاجماع عضوا عاملا فيه (سنة 1964م / 1383ه) كما انتخب عضوا مراسلا في كل من مجامع اللغة العربية في القاهرة (عام 1967م / 1386 ه) (ينظر الملحق الخامس والعشرون)، وفي دمشق (عام 1973م
ص: 451
/ 1392 ه) و ( الأردن عام 1980م / 1398ه) وشارك في العديد من المؤتمرات المنعقدة بين المجمع العلمي العراقي ومجامع اللغة العربية منها: المؤتمر المنعقد ببغداد (عام 1965م / 1384 ه) بدعوة من المجمع العلمي العراقي والمؤتمر المنعقد بالقاهرة (عام 1967م / 1386 ه ) بدعوة من مجمع اللغة العربية المصري والمؤتمر المنعقد بدمشق (عام 1972م / 1391 ه) بدعوة من اتحاد المجامع العربية حول ندوة المصطلحات القانونية. وقد ألقى في المؤتمر الأول منها بحثه المعنون (الوضع: تحديده تقسيماته، مصادر العلم به)، وألقى في المؤتمر الثاني منها بحثه الموسوم ب(المعنى الحرفي في اللغة بين النحو والفلسفة والأصول )(1).
ولقد كان يوما مشهودا في تاريخ منتدى النشر يوم وضع الحجر الأساسي لبنايتها الجديدة ففي يوم الخميس الموافق 29 ذي القعدة (سنة 1371 ه/ 1952م) قررت جمعية منتدى النشر أن تحتفل فيه بوضع الحجر الأساسي لبناية كليتها الدينية جنب الصحن العلوي الشريف بكلمة لسكرتيرها العام سماحة السيد محمد تقي الحكيم تناول فيها الظروف الصعبة التي قطعتها الجمعية والأموال الكثيرة التي صرفتها على تعميرها حتى أصبحت لائقة لضم مدرستها الابتدائية ومتوسطتها وكليتها وإدارة مجلتها وبعض لجانها.(2).
ثم ختم الاحتفال سماحة الشيخ محمد رضا المظفر المعتمد العام للجمعية بكلمة خاطب فيها الإمام علياً (عَلَيهِ السَّلَامُ) بما يحدد مسارات عمل مشروع منتدى النشر فقال سيدي أبا الحسن ها نحن أولاء نحط رحالنا على بابك مستجيرين بك ولائذين بحرمك الطاهر ومستشفعين بروحانيتك وقدسيتك، لنكون قرة عين لك في أداء ما علينا من رسالة دينية في هذا العصر الطاغي بالمادة وفساد الأخلاق، عسى أن نسير على الخطى التي رسمتها لأمثالنا من رجال الدين في الجهاد والتضحية وخلوص النية للواحد القهار.
ص: 452
ونعوذ بالله أن نكون في أعمالنا واتجاهاتنا ممن يشين بلادك المطهرة، فنسيء إلى جوارك ونخرج على مبادئك القويمة، وخير لنا ولأمتنا أن يحال بيننا وبين إكمال هذا العمل إذا كانت نتائجه تنتهي إلى غير الهدف الأعلى الذي جعلناه لمؤسستنا من السعي لإعلاء كلمة الحق والإسلام في تربية الناشئة الدينية تربية صحيحة، ونبتهل إلى اللّه تعالى أن يضفي علينا من ظلالك الوارف على مجاوريك ما يأخذ بناصرنا إلى الحق وما يقوي في نفوسنا الإرادة وصدق العزيمة وما يجعل منا أمناء على الدين لا نخون فيه عهدك ولا نحيد عن صراطك المستقيم. اللهم اسمع واستجب ومنك التوفيق والتسديد. اللهم اشهد على نياتنا وأنت أعلم بها منا. اللهم لا تخيب سعينا ولا تقطع رجاءنا إنك حميد مجید(1).
وقد ضم صندوق الحجر الأساسي الذي وضعه سماحة السيد محمود الحكيم بيده أسماء الهيئة المؤسسة لجمعية منتدى النشر وهم أصحاب السماحة والفضيلة: الشيخ جواد قسام، والشيخ عبد الهادي حموزي، والشيخ محمد رضا المظفر، والسيد محمد علي الحكيم، والسيد موسى بحر العلوم، والسيد هادي فياض، والسيد يوسف الحكيم. وأسماء من تعاقب على الهيئة المشرفة وهم أصحاب السماحة: السيد سعيد الحكيم، والشيخ عبد الحسين الحلي، والسيد محمود الحكيم، والشيخ محمد حسين المظفر، والشيخ محمد طه الكرمي، والشيخ مرتضى آل ياسين.
وضم الصندوق أسماء ثلاثين ممن تعاقبوا على الهيئة الإدارية للجمعية واشترك جلّهم التدريس بالكلية أذكر منهم أصحاب السماحة السيد يوسف الحكيم، والشيخ محمد رضا المظفر، والشيخ محمد جواد آل راضي، والسيد محمد علي الحكيم، والسيد موسى بحر العلوم، والسيد محمد تقي الحكيم، والشيخ محمد الشريعة. كما ضم الصندوق أيضا أسماء 16 عضوا آخرين من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى أسماء 23 من المؤازرين أذكر
ص: 453
منهم : سماحة المرجع السيد أبو الحسن الأصفهاني، والشيخ محمد رضا الشبيبي، والشيخ علي الشرقي، والسيد عبد المهدي المنتفكي، والسيد ضياء جعفر.(1)
وقد قاسی رواد مشروع منتدى النشر كما سمعت من بعضهم الأمرين ممن لا يعرف أهميته أو خالج ذهنه الريب منه أو لأسباب أخرى لا مجال لذكرها مما دفع بعضهم إلى سؤال سماحة الشيخ محمد رضا آل ياسين فأجاب في 15 من شهر ذي القعدة من (عام 1363 ه/ 1944م) بما يشعر بحراجة ما عاناه روادها ذلك الوقت بقوله: سألت أيدك اللّه عن رأينا في مدرسة منتدى النشر الدينية في النجف الأشرف. نعم اطلعت على مناهجها القويمة ومبادئها الدينية المستقيمة التي قد أخذت الهيئة العامة المحترمة القائمة بشؤونها تطبيقها عملا بكل همة ونشاط ودقة واحتياط، فظهر لنا بالرغم عمّا كان يختلج في أذهان البعض منا من الريب في أمرها أنها مؤسسة دينية علمية أخلاقية لا هم لمؤسسيها الكرام على ما يشهد به أعمالهم سوى تثقيف طلابها بالمعارف الإلهية والعلوم الدينية والأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية. فشكر اللّه مساعيهم وبارك لهم وفيهم ونسأله تعالى لهم التأييد والتسديد ولمدرستهم التقدم والنجاح ولطلابها التوفيق للعلم والعمل الصالح(2).
هذا وقد عاودت الجمعية نشاطها مجددا بعد سقوط النظام البائد فشكلت هيئة إدارية جديدة تم انتخابها بالاقتراع السري وفق النظام الداخلي للجمعية، وعمدت إلى مزاولة أنشطتها السابقة فباشرت بطبع الكتب المحققة وغيرها، وإقامة المواسم الثقافية - وقد حضرت بعضها - وفتح المدارس لمرحلة ما قبل الجامعة، كما أتمت وضع اللبنات الأولى لإعادة فتح كلية الفقه الأهلية، عسى أن تتم المباشرة بقبول الطلاب وتحديد الملاك التدريسي قريبا إن شاء اللّه تعالى.
ص: 454
(1) مقدمة كتاب مالك الأشتر : 7 -8.
(2) من مذكرات الشيخ محمد رضا المظفر الخطية. نقلا عن كتاب: الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. سابق : 96.
(3) من مقدمة كتاب: حقائق التأويل في متشابه التنزيل. الشريف الرضي : 4.
(4) ينظر : نظام منتدى النشر الصادر في آب من عام 1370 ه/ 1951م.
(5) منتدى النشر بعد 16 عاما.
(6) من مقدمة كتاب : حقائق التأويل في متشابه التنزيل. سابق : 4 - 5.
(7) نظر رحلتي الدراسية مع السيد التقي الحكيم. د. محمود المظفر بحث منشور ضمن كتاب السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف : 356.
(8) ينظر نص رسالة الشيخ المظفر في مجلة العرفان الجزء الثامن والتاسع. المجلد 29 من سنة 1930م.
(9) الدوافع والأهداف الشيخ محمد مهدي شمس الدين بحث مخطوط بقلمه: 4-5
(10) المصدر السابق 5-6
(11) المنتدى تاريخ وتطور. أضواء على الفكرة. السيد محمد تقي الحكيم. مجلة النجف. العدد 2 من السنة الثالثة. 1968م / 1388ه ص: 81-82.
(12) المصدر السابق : 83 - 84.
(13) منتدى النشر أعماله وآماله الشيخ محمد رضا المظفر: 8.
ص: 455
(14) منتدى النشر بعد 16 عاما.
(15) منتدى النشر أعماله وآماله : 9.
(16) منتدى النشر بعد 16 عاما ح.
(17) منتدى النشر. الشيخ محمد رضا المظفر بحث مجلة العرفان العدد: 8 و 9 المجلد 29 لسنة 1358 ه- 1940م.
(18) ينظر : نظام منتدى النشر لسنة 1370ه الصفحة : ح وما بعدها.
(19) نظام كلية الفقه في النجف الأشرف: 5.
(20) رحلتي الدراسية مع السيد التقي الحكيم. سابق : 353
(21) الشاعر الهادف الشيخ محمد علي اليعقوبي. بحث بقلم السيد محمد تقي الحكيم. سابق
(22) تنظر : موسوعة عن قتل واضطهاد مراجع الدين وعلماء وطلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية (العراق). د. صاحب الحكيم: 3/ 2340 - 2344.
(23) نظام كلية الفقه في النجف الأشرف: 7
(24) المصدر السابق7.
(25) نظام جمعية منتدى النشر : 23.
(26). منتدى النشر بعد 16 عاما: ز.
(27) الشاعر الهادف الشيخ محمد علي اليعقوبي مقال. السيد محمد تقي الحكيم. مجلة الإيمان السنة الثانية. العدد 7-10 لسنة 1386 ه- 1966م. وينظر: المصدر السابق أيضا.
(28) المرجعية الدينية. الحلقة الثانية. حوار صريح مع سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم. إعداد وتقديم عبد الهادي السيد محمد
ص: 456
تقي الحكيم: ط5 : 116.
(29) مقدمة كتاب أسبوع الإمام وهو مجموعة محاضرات أصدرها المجمع الثقافي الديني لمنتدى النشر. بقلم السيد محمد تقي الحكيم: 7.
(30) مقدمة كتاب مالك الأشتر للسيد محمد تقي الحكيم بقلم الشيخ محمد رضا المظفر: 11.
(31) مشكلة الأدب النجفي. السيد محمد تقي الحكيم. مجلة النجف. العدد 3 من السنة الأولى 1956 - 1957م.
(32) من مقدمة كتاب النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين بقلم السيد محمد تقي الحكيم: 63-64
(33) ينظر: المصدر السابق
(34) مقدمة كتاب مالك الأشتر. سابق : 12.
(35) مالك الأشتر سابق : 120.
(36) المصدر السابق: 121
(37) المرجعية الدينية. الحلقة الثانية. حوار صريح مع سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم. سابق : 117.
(38) ذكرياتي عن أستاذي آية اللّه السيد محمد تقي الحكيم. د. حازم الحلي. بحث منشور ضمن كتاب: السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف : 323.
(39) المصدر السابق: 322.
(40) هكذا عرفتهم. جعفر الخليلي: 2/ 24.
(41) المصدر السابق : 1 / 246.
(42) الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. سابق: 109.
ص: 457
(43) من مقدمة النص والاجتهاد. سابق : 62.
(44) عقائد الإمامية. الشيخ محمد رضا المظفر : 22.
(45) المصدر السابق طبعة القاهرة: 52.
(46) رسالة خطية تحتفظ أسرته بنصها
(47) رسالة خطية من الشيخ محمد محمد المدني له تحتفظ أسرته بنصها
(48) من مقدمة كتاب التشيع في ندوات القاهرة للسيد محمد تقي الحكيم. بقلم الدمرداش العقالي : 23.
(49) أسس الدراسة الأصولية المقارنة عند العلامة الحكيم..د عبد الجبار شرارة. بحث منشور ضمن كتاب السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف : 291.
(50) الأصول العامة للفقة المقارن. السيد محمد تقي الحكيم: 10.
(51) أسس الدراسة الأصولية المقارنة عند العلامة الحكيم. سابق: 294.
(52) السيد الحكيم نافذة النجف ذات الأبعاد الفكرية على العالم الإسلامي د. السيد محمد بحر العلوم. بحث منشور ضمن كتاب السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف : 24.
(53) رحلتي الدراسية مع السيد التقي الحكيم. سابق : 351.
(54) السيد الحكيم نافذة النجف ذات الأبعاد الفكرية على العالم الإسلامي. سابق : 25
(55) الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف : 81.
(56) في الأدب النجفي قضايا ورجال. محمد رضا القاموسي: 118.
(57) المصدر السابق: 131.
ص: 458
(58) ذكريات عن أستاذي آية اللّه السيد محمد تقي الحكيم. سابق: 338.
(59) المصدر السابق : 337
(60) المصدر نفسه.
(61) ينظر مثلا القصائد التالية في الديوان الرمادها ورماد الوطن : 205 - 208، مصارع الشهداء: 209 - 218، على ضفاف الغدير : 219- 230، من أمس الأمة إلى غدها: 231 - 242، يقظان 257 - 267، معلم الأمة : 283۔ 293، الفقيدان : 298 - 304.
(62) يقصد بذلك نظام صدام حسين فترة ما بعد غزو الكويت وإجهاض الانتفاضة الشعبانية سنة (1411ه/ 1991م).
(63) محنة الأهوار والصمت العربي الدكتور السيد مصطفى جمال الدین: 30-31.
(64) المصدر السابق : 32.
(65) المصدر نفسه.
(66) الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. سابق: 77-78.
(67) مجلة النجف السنة الثانية. العدد 31, 10 تموز 1958م. ص: 25.
(68) محنة الأهوار والصمت العربي سابق: 30 وما بعدها.
(69) الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. سابق 80- 81.
(70) قانون منتدى النشر : 4
(71) نظام كلية الفقه 2
(72) المصدر السابق : 3-4.
(73) من مقدمة سماحة الشيخ محمد رضا المظفر لكتاب مالك الأشتر للسيد محمد تقي الحكيم: 11.
ص: 459
(74) روى الأستاذ محمود شيت خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية وعضو المجمع العلمي العراقي والشيخ محمد رضا المظفر من أعضائه أيضا، قال: إنه تلقى المجمع العلمي قبل مدة وجيزة من مجمع اللغة بمصر رسالة حول موضوع من المواضيع وقد قرأنا الرسالة كلنا وقرأها الشيخ محمد رضا ولكن المظفر لفت نظرنا إلى ورود خمسة أغلاط لغوية في تلك الرسالة. وقال إنه لم يكن من الأدب تسقط السهو والغلط في الرسائل التي تردنا لو لم يكن مصدر هذه الرسالة مجمعا لغويا الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. سابق : 70، نقلا عن جريدة البلد البغدادية في 25 / 2 / 1964م / 1384ه.
(75) السيد الحكيم نافذة النجف ذات الأبعاد الفكرية على العالم الإسلامي. سابق : 25.
(76) حفلة وضع الحجر الأساسي لبناية كلية منتدى النشر في النجف الأشرف سنة 1953 م: 18.
(77) المصدر السابق : 35.
(78) المصدر نفسه: 41 - 42.
(79) ينظر صورة كتاب سماحة الشيخ بخط الشيخ نفسه في المصدر السابق: 44.
ص: 460
ص: 461
ص: 462
سأتحدث في هذا الفصل عن نظام جديد اتبعته حوزة النجف الأشرف العلمية سار علیه و عمل به قسم من طلابها موضحا إياه في النقاط التالية:
أولا - بعد أن عادت الحوزة العلمية في النجف الأشرف لالتقاط أنفاسها إثر زوال الكابوس الجاثم على صدرها بزوال النظام الصدامي البائد سعت لتأليف لجنة سميت ب(اللجنة المشتركة) تقوم بالتنسيق بين مكاتب المراجع الأربعة العظام: سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، وسماحة السيد المرجع الكبير محمد سعيد الحكيم وسماحة المرجع الشيخ إسحاق الفياض وسماحة المرجع الشيخ بشير النجفي (دام ظلهم هدفها ترتيب وتنظيم ومتابعة شؤون طلبة حوزة النجف الأشرف العلمية، فقامت هذه اللجنة بفتح مكتب وتوزيع استمارات خاصة على الطلبة، تحتوي على أهم ما يمكن معرفته ومتابعته من قبلها من معلومات متعلقة بدراسة الطالب، والمناهج المقررة، والرواتب، والسكن، وغير ذلك مما يرتبط بالوضع الدراسي للطالب واحتياجاته علمية ويومية.
وتحتوي الاستمارة على حقل يجيب عنه الطالب من خلال سؤاله عما يفضله من طريقة الحصول على الراتب المحدد له من قبل المراجع العظام كي يختار الطالب أحد جوابين ل(حقلين): إما التقييم أو الامتحان.
أما التقييم : فهو عبارة عن قيام (اللجنة المشتركة) باستحصال المعلومات وجمعها فيما يتعلق بالطالب من أمثال مدى استمراره على الدراسة، ومدى التزامه الديني
ص: 463
والأخلاقي وغيرها، ثم وبعد الحصول على تلك المعلومات تقوم اللجنة بكوادرها المختصة بدراسة هذه المعلومات المتعلقة بالطالب وتقييمها ووضع درجة تتلاءم وتلك المعلومات، وهذه الدرجة : إما (مقبول) فلا داعي لامتحانه، وإما (يبلغ بالامتحان).
يعطى المقبولون بالتقييم مار الذكر (كارتات) من قبل مكاتب المراجع الأربعة العظام ( ينظر الإحصائية رقم 1)، في حين يحوّل (المبلغون بالامتحان) إلى مكتب سماحة المرجع السيد الحكيم دام ظله الذي هو عضو من أعضاء اللجنة المشتركة مقدمة للامتحان (ينظر الإحصائيتين 2و3)، ذلك ان مكاتب المراجع العظام أناطت به مهمة أخرى، وهي الإشراف على امتحانات الطلبة وإدارتها بالكامل لما لهذا المكتب من خبرة وأسبقية بهذا الجانب، حيث كان وقبل أكثر من عشر سنوات لا يعطي مكتب المرجع الحكيم لطالب الحوزة الراتب إلا إذا اجتاز الامتحان الذي يقيمه المكتب له.
وعندها يملأ الطلبة (المبلغون بالامتحان) مع الطلبة الذين اختاروا (الامتحان) ابتداءً استمارة ينظمها مكتب المرجع السيد الحكيم (دام ظلّه) تتعلق بالامتحانات، ويتم ملء الاستمارات الامتحانية في فترة يحددها المكتب، ثم تقوم اللجنة الامتحانية في مكتب السيد الحكيم (دام ظلّه) بإعداد كل المستلزمات الضرورية لتقييم المستوى العلمي لطالب الحوزة وكل ما يتعلق بالامتحان من إعداد الجداول والإعلانات والأسئلة ولجان المراقبة والتصحيح وغير ذلك.
حيث يبدأ الطالب امتحاناته السنوية بما يتناسب والمرحلة الدراسية التي هو فيها فإذا اجتاز الامتحان بنجاح يطالب بعد سنة من تأريخ امتحانه السابق بمواد أعلى من تلك المرحلة التي اجتازها، ففي علم الفقه يمر الطالب بمراحل امتحانية ست باجتيازها ينهي السلم الامتحاني للفقه.
ص: 464
بينما يمر الطالب في علم النحو بأربع مراحل امتحانية وفي علم المنطق عليه ان يجتاز ثلاث مراحل امتحانية بينما تكون مرحلة علم الأصول أقل المراحل حيث تتكون من مرحلتين امتحانيتين فقط. وعلى الطالب أن يجتاز كل مرحلة من المراحل المتقدمة في ظرف سنة واحدة، فإذا وصل إلى مرحلة الفقه والأصول ما قبل الأخيرة واجتازها بنجاح يعطى ثلاث سنوات يستمر فيها على تقييمه في تلك المرحلة ثم يطالب بمواد المرحلة المنتهية.
علما أن الراتب الشهري لطالب مرحلتي الفقه والأصول قبل الأخيرة يكون بزيادة عما سبق من المراحل في حين تكون المرحلة المنتهية أعلى المراحل في سلم الرواتب.
وبعد الانتهاء من ذلك كله يحدد المكتب من خلال لجنته الامتحانية فترة لإعلان النتائج التي حاز عليها كل طالب، وعلى ضوء النتائج المعلنة ترتب سلالم الرواتب حيث يقوم مكتب السيد الحكيم (دام ظلّه) بتزويد (اللجنة المشتركة) المتقدم ذكرها بالنتائج الكاملة للطلبة لتقوم مكاتب المراجع العظام على ضوء ذلك بإعداد الكارتات للطلبة الناجحين، وتستمر بتسليمهم دفعات الرواتب الشهرية المخصصة لكل منهم حسب مستواه الدراسي، لمدة سنة كاملة، ثم يطالبون بمواد أعلى في السنة القادمة، عليهم أن يثبتوا أنهم درسوها بمستوى لائق وهكذا.
أما الطلبة الذين لم يجتازوا الامتحان بأن تخلفوا بمادة أو مادتين فيتم مطالبتهم بعد ستة أشهر بامتحان الدور الثاني. علماً أن درجة النجاح المحددة للإمتحان هي 70%.
ثانيا - فيما يأتي سبع إحصائيات لست سنوات (1426 - 1431 ه / 2005 - 2010م) جرى في (سنة 1431 ه منها امتحانان للطلبة) أوردها متسلسلة حسب تواريخها وكما يأتي:
ص: 465
إحصائية رقم (1) بالطلاب المسجلين والمشتركين
في امتحان الحوزة لعام 1426ه / 2005م
المادة الامتحانية عدد المسجلين عدد المشتركين
منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 1 244166
منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 2 3026
منطق الشيخ المظفرج 1 190137
منطق الشيخ المظفرج 26132
قطر الندى ج 1 135104
قطر الندى ج23224
شرايع الإسلام ج 1 3516
شرايع الإسلام ج 2 104
شرايع الإسلام ج 3 5229
حاشية الملا عبد اللّه في المنطق ج 1 2211
ألفية ابن مالك ج 1 3116
ألفية ابن مالك 2 44
أصول الفقه للشيخ المظفر 5952
اللمعة الدمشقية 5852
الكفاية 128
المكاسب للشيخ الأنصاري 128
المجموع 917691
ص: 466
إحصائية رقم (2) بالطلاب المسجلين والمشتركين
في امتحان الحوزة لعام 1427ه/ 2006م
المادة الامتحانية عدد المسجلين عدد المشتركين
منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 1533437
منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 2 8784
منطق الشيخ المظفرج 1 514400
منطق الشيخ المظفر ج 2 8757
قطر الندى ج 1 375290
قطر الندى ج 2 6345
شرايع الإسلام ج 1 6446
شرايع الإسلام ج 2 93
شرائع الإسلام ج 3 3626
حاشية الملا عبد اللّه في المنطق ج 1 4626
ألفية ابن مالك ج 1 3626
ألفية ابن مالك ج 2 85
أصول الفقه للشيخ المظفر 16094
اللمعة الدمشقية 16194
الكفاية 5431
المكاسب للشيخ الأنصاري 5326
المجموع 22861708
ص: 467
إحصائية رقم (3) بامتحانات طلاب الحوزة
لشهر جمادى الثانية من عام 1428ه/ 2007م
المادة الامتحانية عدد المسجلين عدد المشتركين
منهاج الصالحين للسيد الخوئي/ ج 1 277217
منهاج الصالحين للسيد الخوئي / ج 2 357247
قطر الندى وبل الصدى / ج 1 222134
قطر الندى وبل الصدى / ج 1 345233
حاشية الملا عبد اللّه فى المنطق 6839
ألفية ابن مالك / ج 1 6641
ألفية ابن مالك / ج 2 138
شرائع الإسلام / ج 1 5231
شرائع الإسلام / ج 2 63
شرائع الإسلام / ج 3 7853
منطق الشيخ المظفر / ج 1 291212
منطق الشيخ المظفر / ج 2 358200
اللمعة الدمشقية 247170
أصول الفقه للشيخ المظفر 270162
المكاسب 3928
الكفاية 4635
للجموع 27351840
ص: 468
إحصائية رقم (4) بامتحانات طلاب الحوزة
لشهر ربيع الثاني من عام 1429 ه / 2009م
المادة الامتحانية عدد المسجلين عدد المشتركين
منهاج الصالحين للسيد الخوئي/ج1336276
منهاج الصالحين للسيد الخوئي / ج 2 244175
قطر الندى وبل الصدى / ج 1 272202
قطر الندى وبل الصدى / ج 1 283154
حاشية الملا عبد اللّه في المنطق 5328
ألفية ابن مالك / ج 1 6532
ألفية ابن مالك / ج 2 139
شرائع الإسلام / ج 1 3827
شرائع الإسلام / ج 2 84
شرائع الإسلام / ج 3 4938
منطق الشيخ المظفر / ج 321246
منطق الشيخ المظفر / ج 2 279140
اللمعة الدمشقية 435346
أصول الفقه للشيخ المظفر 469296
المكاسب 5427
الكفاية 5429
للجموع 29732029
ص: 469
إحصائية رقم (5) بامتحان الحوزة
لشهر شعبان من عام 1430 ه/ 2010م
المادة الامتحانية عدد المسجلين عدد المشتركين
منهاج الصالحين للسيد الخوئي / ج 1 410309
منهاج الصالحين للسيد الخوئي / ج 2 256182
قطر الندى وبل الصدى / ج 1 308122
قطر الندى وبل الصدى / ج 1 224114
حاشية الملا عبد اللّه في المنطق11653
ألفية ابن مالك / ج 1 11460
ألفية ابن مالك / ج2 3014
شرائع الإسلام / ج 1 7135
شرائع الإسلام / ج 2 106
شرائع الإسلام / ج 3 5842
منطق الشيخ المظفر / ج 1386287
منطق الشيخ المظفر / ج 2 251104
اللمعة الدمشقية 705557
أصول الفقه للشيخ المظفر 760482
المكاسب 9754
الكفاية 9568
للجموع 38912489
ص: 470
إحصائية رقم (6) بامتحان طلاب الحوزة
لشهر ربيع الثاني من عام 1431 ه/ 2011م
المادة الامتحانية عدد المسجلين عدد المشتركين
منهاج الصالحين للسيد الخوئي / ج 1 375256
منهاج الصالحين للسيد الخوئي / ج 2 12768
قطر الندى وبل الصدى / ج 1 19076
قطر الندى وبل الصدى / ج 2 16253
حاشية الملا عبد اللّه في المنطق 5720
ألفية ابن مالك / ج 1 8747
ألفية ابن مالك / ج2 219
شرائع الإسلام / ج 1 4427
شرائع الإسلام / ج 2 83
شرائع الإسلام / ج 3 3730
منطق الشيخ المظفر / ج 245231
منطق الشيخ المظفر / ج 2 14054
اللمعة الدمشقية 833574
أصول الفقه للشيخ المظفر 758469
المكاسب 17651
الكفاية 194109
للجموع 34542077
ص: 471
إحصائية رقم (7) بنتائج امتحان الحوزة
لشهر ذي القعدة من عام 1431 ه/ 2011م
المادة الامتحانية عدد المسجلين عدد المشتركين
منهاج الصالحين للسيد الخوئي / ج 1 187143
منهاج الصالحين للسيد الخوئي / ج 2 195117
قطر الندى وبل الصدى / ج 1 11170
قطر الندى وبل الصدى / ج 2 16768
حاشية الملا عبد اللّه في المنطق1515
ألفية ابن مالك / ج 1 9639
ألفية ابن مالك / ج2 2810
شرائع الإسلام / ج 1 4322
شرائع الإسلام / ج 2 123
شرائع الإسلام / ج 3 4727
منطق الشيخ المظفر / ج 1208163
منطق الشيخ المظفر / ج 2 19583
اللمعة الدمشقية 578435
أصول الفقه للشيخ المظفر 595352
المكاسب 16075
الكفاية 14392
للجموع 27801714
ص: 472
ثالثاً - تمثل أعداد الطلبة المشاركين في الامتحان العام لطلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف نافذة من النوافذ التي يمكن من خلالها قراءة مجريات ومسيرة الدراسة في هذه المؤسسة التعليمية العريقة ومع أن الانضمام إلى الحوزة هو أمر طوعي واختياري وليس له حد أعلى أو أدنى من حيث عدد المقاعد وطلاب كل مرحلة، فإن ظروفا أخرى محيطة بالحوزة العلمية كان لها تأثير مباشر على وضع الطلبة الدراسي تأتي في مقدمتها الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.
ذلك أن الذي يطلع على بعض الإحصائيات ينكشف له تأثير مجريات الأحداث السياسية في العراق وخاصة في مرحلة الانتقال العنيف من نظام حكم شمولي قاهر كان جل اهتمامه قمع الحوزة العلمية ومن ينتسب إليها إلى نظام رافع الراية الحرية الفكرية والسياسية وهو ما أعطى فرصة للحوزة العلمية بالتوسع وفتح المجال واسعا أمام الراغبين بالانخراط ضمن صفوفها ولجميع المراحل الدراسية للالتحاق بها، بل وإن الأمر تعدى إلى ما هو أكبر من ذلك حيث ان الطلبة في بعض الحوزات العلمية خارج النجف الأشرف بدأوا يزحفون زرافات ووحدانا إلى حوزة النجف الأشرف ليلتحقوا بها بعد أن اطمأنوا من زوال النظام الاستبدادي الطائفي الذي كان جاثما حد الخنق على صدر العراق وصدر حوزة النجف الأشرف العلمية، وينكشف ذلك من خلال تزايد أعداد الطلبة كما ونوعا كما يظهر ذلك من الإحصائيات المرفقة (ينظر الملحق السادس والعشرون).
ص: 473
ص: 474
ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث هي:
المبحث الأول : مدرسة الإمام الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) للطلاب في النجف الأشرف.
المبحث الثاني : مدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية بقسميها الرجالي والنسائي
المبحث الثالث: مدرسة دار العلم النسائية للعلوم الدينية.
ص: 475
ص: 476
نشأت البذرة الأولى لمدرسة الإمام الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) عام 1415 ه- 1995م في مدينة قم المقدسة إثر ظروف الهزة القاسية التي عصفت بالوسط المتدين في العراق فشردته في أرض اللّه الواسعة الأطراف، وبعثرت جهوده هنا وهناك، وكان جيل التأسيس فيها جمعا من السجناء السياسين الإسلاميين الذين جمعتهم جدران سجن أبي غريب بين عامي (1403 - 1411 ه- / 1983 - 1991م) مع مؤسس المدرسة سماحة السيد حسين نجل الشهيد السعيد السيد علاء الدين الحكيم أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية، وعضو اللجنة المشرفة السيد محمود نجل الشهيد السعيد السيد مجيد الحكيم مما أسس لعلاقة أخلاقية وعلمية وإنسانية وتربوية بين الجمع الفاضل من السجناء السياسيين على درجة كبيرة من الود والتواصل والتدارس وطرح مشاكل ومعوقات المعاناة العامة للمؤمنين والتفكير في الهم المشترك والبحث عن الحلول.
لقد قادت هذه المداولات المشغولة بالبحث عن الحلول الأكثر نفعا في خضم المكابدة العامة إلى محاولات عملية مهدت السبل لافتتاح مدرسة علّها تسد بعض الحاجة المشخصة من خلال إعداد كوادر علمية جادة حريصة على الاستفادة من الوقت والجهد ما أمكن.
ولاقت المدرسة بعد افتتاحها نجاحا كبيرا في الوسط العراقي المهجر من بلده كرها، وقد بدا واضحا من خلال كثرة من تقدم بطلبات للانتساب اليها رغم الشروط
ص: 477
الصعبة التي وضعتها المدرسة لقبول المتقدمين اليها.
وكان من أهم ما شخصه مؤسسها منذ اللحظة الأولى للتاسيس ان العراق سيكون بامس الحاجة إلى العلماء العاملين بعد سقوط نظام صدام لكثرة من استشهد من هؤلاء العلماء ومن عجز تحت الضغط والترهيب المتواصل عن القيام بدوره خير قيام، ناهيك عن من تعرض منهم للسجن والحجز والتهير والمحاصرة والتعذيب المعطل عن العمل، مما ادى إلى انخفاض عدد طلاب وعلماء الحوزة العلمية في النجف من عشرة آلاف أقل أو أكثر قليلا إلى مئات فقط عند تاسيس المدرسة.
وينطلق سماحة السيد حسين الحكيم من دراسة لمعدلات نسب عدد طلاب الحوزة وعلمائها إلى عدد السكان من اتباع أهل البيت في بلدانهم، فيجد ان المعدل العام في لبنان والبحرين وايران وتركيا والسعودية والكويت وافغانستان هي بمعدل (عالم أو طالب علم واحد) لكل (950) مواطن تقريبا، وحينما نطبق هذه الدراسة على الواقع العراقي القائم اليوم نجد ان عدد طلاب الحوزة حوالي (5000) طالب بينما يبلغ عدد السكان من الشيعة حوالي (18) مليون نسمة مما يعني أن النسبة هي (طالب حوزوي واحد) لكل (3600) مواطن.
إن هذه النسبة تمثل انخفاضا خطيرا جدا في العدد المطلوب إذا قيس بنسبتهم في البلدان المجاورة، أما إذا قيس بما تستلزمه الحاجة الفعلية للمواطنين التي تفوق النسبة السابقة بكثير فسيبدو لنا الأمر مقلقا.
وهو ما يمكن ان يفسر لنا الكثير من الظواهر الغريبة على الواقع العراقي التي تصاحب عادة انخفاض المعدل العام للثقافة الدينية من قبيل ادعاء المهدوية، او الارتباط المباشر بالامام المهدي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فضلا عن ادعاء المرجعية من قبل غير المؤهلين لها
ص: 478
وفق السياقات الحوزوية المعروفة.
وبما ان التفقه في الدين من الواجبات الكفائية التي تجب على الجميع ان لم ينهض بها من به الكفاية منهم، فإنه ذهب إلى تشخيص مفاده: ان العمل الحوزي وتشجيع الشباب الكفوئين على الانخراط في الحوزة هو من صميم الواجبات الشرعية في العصر الراهن.
ومن هنا انبثقت من مدرسة الامام الكاظم في قم مدرسة اخرى في النجف الأشرف تنطلق من نفس الرؤية والاهداف والمنهج وشروط القبول وجدية الدوام وأمثالها، بل انها حسب تشخيص مؤسسها قد ولدت البنت في قم امها في النجف الأشرف.
والمدرسة الأم في النجف الأشرف اليوم احدى المدارس الحوزوية المهمة التي تولي البعد الأخلاقي في شخصية طلابها، وتنمية روح المثابرة لديهم اهتمامها البالغ.
وتشرف على المدرسة لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يرأسهم سماحة السيّد حسين الحكيم، مؤسس المدرسة.
وتصدر هذه اللجنة مقرّراتها بالأكثرية، وتتحمّل مسؤولية الإشراف المباشر على شؤون المدرسة العامة والجزئية الصغيرة منها والكبيرة وبخاصة ما يتعلق منها بالمناهج ومتابعة تطبيقها كما تنفتح اللجنة على علاقات متميزة بين الأساتذة والطلبة، من خلال الحضور المستمر في المدرسة، وتنظيم زيارات لهم في المناسبات الخاصة والعامّة، إضافة إلى البرنامج الثابت الذي يقوم خلاله رئيس الهيئة المشرفة على المدرسة بزيارات تفقدية لمنازل الطلبة والأساتذة للتعرف والاطلاع عن كثب على ما يعانون من مشاكل ومعوقات بحثا عن الطرق الكفيلة لتجاوزها. اذ يعتقد المشرفون على المدرسة ان اهم عوامل النجاح للطالب بعد الاخلاص للّه وتوفيقه هو بناء علاقة متينة بين جيل الطلبة وجيل الاساتذة تبتني على اداب العشرة الإسلامية وتثمر الحب في اللّه
ص: 479
وتقلل من ضغط الشعور بالغربة لدى الطلاب الذين لا يسكنون في النجف الأشرف وتساهم في اقتداء الطلبة باساتذتهم في دراستهم وسلوكهم العام.
وضعت المدرسة شروطا لقبول طلابها هدفها ان تضمن كفاءة الطالب المعنوية والعلمية لحمل رسالة الإسلام إلى الانسان ومن هنا جاء ضمن شروط القبول فيها ما يأتي:
1. أن يخضع الطالب لامتحان شفهي لاختبار معلوماته الدينية والثقافية وغيرها.
2. ان يوثق الطالب من مكتب من مكاتب المراجع العظام او من وكلائهم او من معتمديهم او من الشخصيات العلمية المعروفة بحيث تطمئن المدرسة إلى (عدالته) التزامه الديني.
أما بالنسبة إلى الكادر الإداري للمدرسة فهو إضافة إلى مديرها يضم موظفين يأخذون على عاتقهم إجراء وتنفيذ القوانين والمقررات التي تصدرها اللجنة المشرفة.
تعتبر المدرسة أن من أولى أهدافها هو بناء الكفاءات العلميّة العالية في الحوزة العلمية التي تعاني في الفترة الأخيرة من ضمور في النوعية وان كانت تعيش ازدهارا تدريجيا في الكمّية، ويتميّز نظامها التعليمي الذي يبتدئ في شهر شوال من كل عام وينتهي بنهاية شهر شعبان من العام الهجري اللاحق بعدّة خصوصيات يمكن إجمالها بما يلي:
1 - أن معدل أيام التحصيل الدراسي (260) يوماً في السنة الواحدة، ويمكن تنفيذ
ص: 480
هذا المعدل العالي من خلال إلغاء العطلة الاسبوعية المعمول بها في الحوزة العلمية في يوم الخميس من كل أسبوع وقصره على يوم الجمعة فقط، إضافة إلى إلغاء العطلة المعمول بها في العديد من الحوزات العلمية للاشهر الثلاثة شهر رمضان المبارك ومحرم الحرام وصفر. وبذلك تكون العطل التي تتخلّل الدوام طوال السنة الزمنية كالتالي:
أ - العطلة الصيفية : ثلاثون يوماً لجميع المراحل.
ب- عطلة نصف السنة: عشرة أيام لكافة المراحل تبدأ مع حلول عيد الفطر المبارك.
ج - أيام شهادات المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ).
د - بعض المناسبات الإسلامية ( كعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الغدير وايام
عاشوراء).
ه- يوم الجمعة من كل أسبوع.
أما نظام الامتحانات السنوية فيها فهو على قسمين:
(الأول) يختصّ بمرحلة الدراسة الأولى وصولا إلى مرحلة اللمعة الدمشقية ويتعرّض فيها الطالب لثماني امتحانات خلال العام الدراسي.
(الثاني) يختصّ بمرحلة المكاسب وما بعدها، وفيه يختصر عدد الامتحانات خلال السنة إلى أربعة إمتحانات فقط.
3- يركز أساتذة المدرسة وحسب توجيهات اللجنة المشرفة على تنمية ملكات الطلبة العلمية من خلال فسح المجال لمناقشتهم وأسئلتهم، إضافة إلى تشجيعهم وإلزامهم في بعض المراحل بكتابة دروسهم، وإعطاء ذلك أهميّة خاصّة.
ص: 481
4 - درجة النجاح التي تعتمدها المدرسة (75%).
5 - لا ينتقل الطالب من مرحلة إلى أخرى إلا بعد أن يكمل منهاج تلك المرحلة كاملة.
6 - يطلب من الطلبة التباحث في ما بينهم في ما درسوه بإشراف من أساتذتهم
ومن الواضح لدى القائمين على المدرسة أنّ هذا النظام المكثف لا يناسب غير ذوي القابليات والهمم العالية من الشباب، ومن هنا فإن عدد المقبولين في كل عام في المدرسة محدود جداً، حيث أن نظام القبول في المدرسة يعتمد على إجراء مقابلة للمتقدم يكتشف من خلالها مقدار استعداده وقدراته، ثم إذا قدر للطالب أن يجتاز مرحلة المقابلة بنجاح وقبل طالبا في المدرسة عندها يمضي الطالب الجديد فترة ستة أشهر انتقالية حيث يتحتم عليه بعدها أن يجتاز امتحانا كي يثبت قبوله نهائياً، كل ذلك مع فسح المجال للطلبة الذين لا يتمكنون من الاستمرار والالتزام بهذا النظام الانتقال إلى مدارس أخرى أقل شروطا، كل ذلك من أجل أن يكون في الحوزة العلمية مدرسة نموذجية تتجاوب مع استعدادات الطلبة المتميزين فقط.
كما أنَّ المدرسة شخصت أنّ مثل هذا النظام يحتاج إلى بعض الخطوات الترفيهية، فخططت لتنظيم سفرات ترفيهية مستمرة في الصيف لتجديد نشاط الطلاب.
تنقسم المدرسة إلى قسمين رئيسين وفق ما خطط لها، هما:
1 - القسم التعليمي: ويتكوّن من سبعة مراحل دراسية تشارف المرحلة الأخيرة منها على إنهاء السطوح العالية والولوج في دروس البحث الخارج
وتيمناً بالأسماء والألقاب لعلماء الطائفة فقد اختارت كل دورة اسما لها من تلك الأسماء وفقاً لرغبة اللجنة المشرفة فكانت أسماءها كما يلي:
ص: 482
1 - دورة سماحة آية اللّه السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه)
2 - دورة الشيخ المفيد (رضوان اللّه عليه):
يتلقى الطلاب فيها يومياً أربعة دروس خلال السنوات الأربعة الأولى ثم تخفَّض بعد ذلك إلى ثلاثة دروس يوميّاً تماشياً مع السُلّم التصاعدي للمواد الدراسية.
تحاول المدرسة ان تقدم للطالب العلوم الدينية الاساسية مع بعض العلوم التي تساهم في صقل قابليات الطالب العلمية وتهيئتهم للتخصص في فروع المعرفة الدينية ومن هنا فإنها تركز على المنهج المألوف في الحوزات العلمية مع بعض الدروس الإضافية التي باتت أساسية من أمثال دراسة علوم القرآن والعقيدة والمنطق والنحو وخلاصات لعلم الفلسفة الإسلامية وغيرها مع تركيز عال على علمي الفقه و أصوله طبعا.
ومن أجل تهيئة المسلتزمات المطلوبة للطالب المشتغل وفرّت المدرسة مكتبة صوتية للاحتفاظ بالمحاضرات وإعارتها للطلبة من أجل الانتفاع بها في مراجعة دروسهم وتلافي ما فاتهم من الدروس، اضافة لمكتبة عامة يستفيد الطلاب من كتبها المتنوعة للمطالعة والبحث حيث تضم بين جنبيها وعلى رفوفها أكثر من اربعة الاف كتاب يستفيد منها الطالب في عمله الدراسي والثقافي العام من خلال القراءة في قاعتها أو للاستعارة الخارجية وهي في تطور مستمر، علما بأن نواة هذه المكتبة كانت من كتب الفقيه الشهيد السيد رضا الخلخالي (قدّس سِرُّه) الذي استشهد على يد أزلام النظام الصدامي بعد الانتفاضة الشعبانية المباركة ( عام 1411ه- 1991م).
القسم التبليغي لمّا كان التبليغ هو الواسطة التي تربط بين العلماء وعلوم أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) والأمة ولأن له الدور الكبير في توعيتها وتوصيل رسالة السماء اليها، فقد
ص: 483
أولت المدرسة لهذا القسم رعاية واهتماما بالغين تجلى في أن تأخذ الهيئة المشرفة على عاتقها مهمة تطوير قابليات طلبة المدرسة والنهوض بهم إلى غاية ما يمكنهم الوصول اليه من مراحل التطور من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتمرينهم نظريا وعمليا على القيام بدورهم المنتظر في عملية إيصال العلوم الإسلامية إلى الفرد والمجتمع، ولذلك فقد حرصت المدرسة على إقامة ندوة أسبوعية لتنمية قابليات الطلبة وتدريبهم والأخذ بيدهم وإعانتهم على صعود السلّم التبليغي مرقاة مرقاة ودرجة درجة، حيث ألزمت برامجها الطلبة كافة على تقديم ما يرون في أنفسهم الكفاءة في تقديمه، بمعنى أن يختار الطالب حسب رغبته واستعداده أربعة محاور كحد أدنى من مجموع عشرة محاور وضعتها اللجنة المشرفة لهم وهذه المحاور هي:
1 - المجلس الحسيني.
2 - كتابة بحث أو مقالة.
3- نظم الشعر أو إنشاده.
4 - تلخيص كتاب
5 - نقد كتاب أو فكرة مخالفة بأسلوب علمي.
6- تدريس مادة علمية.
-7- إيصال مادة من دروس الحوزة العلمية إلى المجتمع.
8- تحقيق موضوع علمي.
9 - محاضرات ارتجالية.
ص: 484
10 - تلخيص حياة أحد العلماء الأعلام.
وتعتبر الندوة الأسبوعية من أهم الدروس فيها، ويشرف عليها اثنان من أساتذة المدرسة المعتمدين الذين يوجهون الطلبة ويقيمون مستوى مشاركاتهم وفق استمارة تقييم خاصة أعدتها المدرسة مسبقا، ويمكن ان تاخذ بعض النتاجات الثقافية للطلبة طريقها إلى النشر من خلال موقع مدرسة الإمام الكاظم على شبكة الاتصالات العالمية (الانترنت) www.alkadhum.org كما تلقى في الندوة محاضرات شهرية من قبل احد اعضاء اللجنة المشرفة او بعض الشخصيات العلمية التي تستضيفها المدرسة حول أهم القضايا الإسلامية الراهنة.
وقد تشرفت بدعوة المدرسة إلى إلقاء محاضرات عن الوضع العراقي الراهن ومدى أهمية تبني فكرة الفدرالية في الوسط والجنوب العراقي كخيار عملي لحل مشاكل العراق وذلك في مقرها السابق في دار سماحة آية اللّه المجدد السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) في شارع الإمام علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) قرب ساحة ثورة العشرين كان أولها بتاريخ 31/ 7/ 2006/ 1427ه واستمرت في السنوات اللاحقة، حيث لاحظت من خلال كثرة الأسئلة اللاحقة للمحاضرة قدرات الطلاب الحسنة على توخي الأسئلة المناسبة وشدة متابعتهم لآخر المستجدات على الساحة العراقية مع حضور طيب منهم للمشاركة والنقاش رغم الظروف غير الطبيعية التي رافقت ذلك اليوم المحدد للمحاضرة صدفة.
هذا وقد سألت السادة المشرفين والطاقم الاداري عن المدرسة تفصيلاً عن المدرسة فخبروني - من جملة ما خبروني به - بأن عدد طلاب السنة الدراسية الحالية (1432 - 1432ه ) (2010 - 2011م ) هو (108) طالباً وجنسياتهم (87 عراقي + 1 سوري + 2 لبناني + 2+ هندي + 16 باكستاني) موزعون على المراحل الدراسية كالاتي:
ص: 485
- طلاب مرحلة المقدمات (57) طالباً.
- طلاب مرحلة السطوح (13) طالباً.
- طلاب مرحلة السطوح العالية (38) طالباً.
وأن الطلبة يتلقون دروسهم في (16) صفاً دراسياً بمساحة 20 متر مربع لكل صف، مع قاعة كبيرة للمحاضرات والندوات اضافة إلى المكتبة.
تمنح المدرسة للطالب حق المشاركة في الامتحانات الموحدة لمكاتب المراجع لغرض تخصيص كارت خاص بكل طالب يستحق بموجبه الراتب الشهري الذي تخصصه مكاتب المراجع العظام لطلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف حسب مستوياتهم العلمية. كما يهيئ القسم الداخلي للمدرسة سكناً ملائماً للطلاب ووجبات طعام يومية لهم. وتقوم المدرسة بتقديم مخصصات سكن مع دعم مالي للحالات الاستثنائية التي قد يبتلى بها الطلبة بشكل متوقع. وقد تخرجت من المدرسة دورتان أهلتا لمرحلة البحث الخارج. وقد حصل قسم من الخريجين على وكالة المراجع العظام في محافظاتهم.
2- أما ملاك المدرسة فقد بلغ عدد اساتذتها عام 2011م / 1432ه كما يأتي: (19) أستاذا لمرحلة المقدمات، و (19) اساتذاً لمرحلة السطوح والسطوح العليا.
3- هذا وقد فتحت المدرسة ابوابها للدراسة المسائية لطلبة الجامعات والمعاهد العلمية وخريجيها حصراً وبلغ عددعم (39) طالباً منهم (10) طللاب المرحلة السطوح على أن نظام الدراسة المتبع في الدراسة المسائية فهو نفس نظام الدراسة الصباحية، وهي فرصة تتيحها المدرسة للتلاحق الفكري بين الحوزة العلمية والجامعة.
4 - كما تخطط المدرسة لدروس اضافية تحاول المدرسة ادراجها لمرحلة السطوح تحت عنوان تأهيل الطالب الحوزوي وتنمية قابلياته وهي دروس تشمل الكومبيوتر
ص: 486
والانترنت وتاريخ التشريع الإسلامي، ومنهج البحث العلمي، وطرق التدريس وغيرها.
كما ادخلت المدرسة بعض المناهج الدراسية التكميلية لبعض المواد مثل دراسة كتاب الأصول العامة للفقه المقارن لسماحة آية اللّه السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) مكملاً لأصول الفقه لسماحة الشيخ المظفر (قدّس سِرُّه) ليأخذ الطالب دورة أصولية كاملة للتهيئة لدرس كفاية الأصول. (ينظر الملحق السابع والعشرون).
ص: 487
.jpg 488^
ص: 488
10. ب مسائي شرائع الإسلام 4 كلهم عراقيون
11.ج / الدوام المسائي منهاج الصالحين 5 كلهم عراقيون
12.د الدوام المسائي منهاج الصالحين 3 كلهم عراقيون
13. ه/ الدوام المسائي منهاج الصالحين 43من العراق و 1 من باکستان
14. و/ الدوام المسائي منهاج الصالحين 6كلهم عراقيون
15.ز/ الدوام المسائي منهاج الصالحين 5كلهم عراقيون
16.ح/ الدوام المسائي منهاج الصالحين 6كلهم عراقيون
المجموع الكلي للطلبة 108 جنسات الطلبة وأعدادهم من كل جنسية
87 طالب عراقي + 1 سوري + 2 لبنانى + هندي +16 باكستاني.
طلاب الدوام الصباحي 6949 طالب عراقي +1 من سوريا + 2 من
لبنان + 2 من الهند + 1 من باكستان
ص: 489
طلاب الدوام المسائي 39 38 طالب عراقی + 1 باكستاني
طلاب المكاسب / كتاب البيع 13كلهم عراقيون
طلاب المكاسب/ المكاسب المحرمة 25كلهم عراقيون
اللمعة الدمشقية 13 كلهم عراقيون
شرائع الإسلام10 كلهم عراقيون
منهاج الصالحين 47 34 طالب من العراق و 1 من سوريا + 2 من لبنان + 2 من الهند + 8 من باكستان
ص: 490
أسس المرجع الأعلى في وقته سماحة السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) مدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية للطلاب في عام (1382ه / 1968م)، وقد ساهمت المدرسة بتربية مجموعة من خيرة الطلاب الذين أصبحوا فيما بعد من العلماء في حوزة النجف الأشرف، وبعد انتفاضة شعبان المباركة في عام (1411ه/ 1991م)، قام النظام البعثي الصدامي بتفجير تلك المدرسة - ذات ال (180) غرفة والبناء المعماري الرائع - بالديناميت، ما أدى إلى تدميرها تدميراً كاملاً وتسويتها بالأرض، كما واجهت الحوزة العلمية المباركة في تلك الأيام واحدة من أقسى المحن التي مرت بها في تاريخها من تدمير للمدارس وإعدام وقتل العلماء والطلبة وزج الآخرين في السجون والمعتقلات والتشريد والملاحقة حتى بلغ الحال باعتقال المرجع الأعلى في زمانه سماحة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه)، ولكم ان تتصوروا ما جرى على من هو دونه من طلابه وتلاميذ مدرسته وغيرهم من طلاب وأساتذة الحوزة العلمية وفضلائها.
وفي عام (1412ه/ 1991م) بادر سماحة الشهيد السعيد آية اللّه السيد محمد باقر الحكيم (قدّس سِرُّه) بإعادة فتح هذه المدرسة المباركة، ولكن في مدينة قم المقدسة، فواصلت
ص: 491
مشوارها الحافل بتربية طلبة العلوم الدينية.
وبعد ان منَّ اللّه سبحانه وتعالى بزوال الكابوس الجاثم على صدور العراقيين، أعيد فتح هذه المدرسة المباركة في مدينة النجف الأشرف وعاودت نشاطها من جديد في ربوع المدينة التي ولدت فيها ورأت النور أول الأمر وترعرعت وأثمرت، وكان تاريخ إعادة افتتاحها الثاني في العراق عام (1423ه/ 2003م).
وبعد ذلك بفترة وجيزة ونتيجة لإقبال الطلاب من الجنسين فتحت مدرستان تحملان الاسم نفسه للمدرسة الأم، أولاهما للرجال وسميت بمدرسة (دار الحكمة للعلوم الإسلامية)، وثانيهما للنساء وسميت بمدرسة (دار الحكمة للعلوم الإسلامية القسم النسوي).
ومما يؤسف له أن المدرستان الوليدتان لم يقدر لهما أن تحضيا بالوقت الكافي برعاية السيد شهيد المحراب (قدّس سِرُّه) وإشرافه فقد اغتالته يد المنون، والمدرستان لا تزالان في بذرتهما الأولى، فواصلتا مشوارهما العلمي بإشراف سماحة السيد عمار الحكيم ثم سماحة السيد حسين الحكيم (المشرف العام الحالي)، وبمرور الزمن أخذت المدرستان كلتاهما تخطوان خطوات جادة نحو الأمام بهدف تربية كوادر رجالية و نسوية مؤهلة للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهما في أمور الدين والعقيدة طبقا لما ورد عن أئمة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).
قد درجت المدرستان على أسلوب الحوزات العلمية في مراحلها الأولية المعتمدة، فقد اعتمدت على مرحلتي : المقدمات والسطوح راسمتين خطة لإنجاز هاتين المرحلتين الدراستين فيما يتراوح ما بين (8-10 سنوات)، معتمدة المناهج المعروفة في الحوزة العلمية مع إضافة بعض المواد الدراسية الإلزامية كالتفسير، والتلاوة، وعلوم القرآن،
ص: 492
والسيرة، والأخلاق. وسأتحدث عن كل من المدرستين فيما يأتي مبتدئا بمدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية :
لقد خطت هذه المدرسة في سنوات قليلة خطوات كبيرة، حيث فتحت فروعاً عديدة في المحافظات الأخرى بما في ذلك بغداد العاصمة، واستقبلت إضافة لطلبة الحوزة العلمية ونخب المجتمع الثقافية وعلى راسها اساتذة الجامعات فكانت حلقة للتواصل بين جناحي الثقافة والعلم وهما الحوزة والجامعة.
- أقسام المدرسة:
تحتوي المدرسة على اقسام علمية وادارية وهي:
1. قسم شؤون الطلبة ويقوم بمهمتين أساسيتين:
- إدارة الشؤون التدريسية للطلبة والأساتذة
-المتابعة التربوية للطلبة.
2. قسم الاقسام الداخلية ومهامه
- تنظيم سكن الطلبة والقيام بما يلزمهم فيه.
- متابعة اشتغالهم وتربيتهم.
3. قسم الإدارة: ويوفر خدمات السكن والطعام والنقل والتنظيف والصيانة وغيرها من القضايا الخدمية التي تعين الطالب على التفرغ لتحصيله واشتغاله العلمي.
ص: 493
4. قسم المالية: ويقوم بتنظيم الحسابات والكشوفات المالية، واستلام الرواتب الشهرية من مكاتب المراجع (دام ظلهم) وتسليمها إلى الطلبة لتوفير أوقاتهم، كما يقوم بتقديم المساعدات اللازمة كمساعدات الزواج والسكن والكسوة الشتوية والصيفية والاحتياجات الأخرى للطلبة.
اعتادت الحوزات الشيعية ان تفتح فروعاً لها في جميع المناطق حتى الصغيرة النائية، وكانت هذه الحوزات المصغرة ترفد حوزة النجف الأشرف وغيرها من الحوزات الكبرى بالكثير من الطلبة الذين يُكملون شطراً من دراستهم في مدنهم. وتكونت بفضل هذه المدارس كيانات علمية، بل وأسر علمية كان لها الاثر في الحفاظ على أحكام وعقائد أبناء مجتمعاتهم واخلاقهم وتوازناتهم الاجتماعية.
إحياءاً لهذه السنة المباركة التزمت (دار الحكمة) بفتح فروع لها في المناطق التي توفرت الظروف الملائمة فيها، وقد تمكنت بعض هذه الفروع من تخريج مجاميع من الطلبة أتموا دراستهم للمقدمات في الفروع ليلتحقوا في مقر المدرسة في النجف الأشرف لدراسة السطوح.
وفروع مدرسة دار الحكمة الفعلية هي :
أولاً: فرع الشامية: وهو من أقدم الفروع تأسيساً حيث تأسس في يوم 2005/11/1، واكتسب أهمية باعتباره الفرع الأول للمدرسة، كما أن طلبته أصبح لهم الاثر الكبير في منطقتهم، ففي وقت لم يكن في الشامية إلّا أقل القليل من طلبة الحوزة، واذا بالمنطقة تعج بالعشرات منهم، فلا توجد مناسبة عامة أو مجلس في مضيف إلّا وتجد حضور بعضهم الفعال مصححاً للمفاهيم وموضحاً للاحكام، مؤثرين
ص: 494
حتى في تغيير طبيعة أحاديث المجالس التي يحضرونها، مؤكدين على ارتباط المؤمنين بمراجعهم، وقد بلغ عدد الطلبة الدارسين في الفرع إلى نهاية الفصل الدراسي الخامس (200) طالباً تقريباً.
ثانياً : فرع سيد محمد (رضیَ اللّهُ عنهُ) في بلد : أسس هذا الفرع بُعيد سقوط النظام البائد سنة 2003 م ثم انضم كفرع إلى مدرسة دار الحكمة لاحقاً، وقد بلغ عدد طلبته أكثر من (150) طالباً. ويكسب أهمية هذا الفرع من ابتعاد المدرسة عن المراكز العلمية وخصوصاً النجف الأشرف وتعيش مدينة بلد ببركات السيد الجليل محمد بن الامام علي الهادي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وضمن محيط يخالف سكنة هذه المدينة في أفكاره العقدية والفقهية، ولكن لم يمنع هذا من التعايش السلمي سابقاً ولاحقاً بين المكونات، مما يضاعف أهميته ومسؤولياته.
وقد تخرجت الدورة الأولى في الفرع من مرحلة المقدمات في شهر (شعبان المعظم / 1431ه / 2010م).
ثالثاً: فرع الزهراء (عَلَيهَا السَّلَامُ) النسوي في بلد: وهو الفرع النسوي الأول للمدرسة، وكان تأسيسه متزامناً مع تأسيس الفرع الرجالي المتقدم ذكره، وبلغ عدد الطالبات فيه أكثر من (80) طالبة.
وقد اثر هذا الفرع في مدينته تأثيراً واضحاً مع التزام اخلاقي كبير، ونشاط متميز في الحركة الثقافية ورغبة جادة في مواصلة الدراسة الحوزوية إلى أعلى مستوياتها.
وقد تم تخريج الدورة الأولى من طلبة مرحلة المقدمات.
علما بأن المدرسات هن من النساء المؤمنات والطالبات الحوزويات المثابرات.
رابعاً: فرع المحقق الحلي في الحلة: تعتبر مدينة الحلة من المدن الشيعية المهمة
ص: 495
والمراكز العلمية والحوزوية ذات التاريخ العريق، ورغبةً من المدرسة في إعادة مجدها الديني الأول ومقامها العلمي المتيمز، فقد تم فتح الفرع فيه، وهو يحمل اسم عالم من أكابر أعلامنا وهو الشيخ أبو جعفر المحقق الحلي، وقد التف العديد من الحليين حول هذا الفرع، فتوسع إلى خارج المبنى المحدد له، حيث فتحت حلقات دراسية تابعة للمدرسة في أقضية المحافظة ونواحيها.
لقد بلغ طلبة الفرع أكثر من (120) طالباً وقد تخرجت الدورة الأولى لمرحلة المقدمات، وتم انتقالهم إلى مرحلة السطوح.
خامسا : فرع الكاظمية المقدسة : لا يشك أحد في الأهمية الكبرى لمدينة بغداد في تحديد مسارات الحياة في العراق، بل وينعكس تاثيرها إلى مدى أبعد، وقد أثبت أهل بغداد عمق ولائهم لأهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) ودفعوا من دمائهم الزكية وجهودهم وأموالهم لأجل هذا الولاء والحب. وتعد مدينة الكاظمية المقدسة جوهرة عقد بغداد التي هي أمان لبغداد ببركة الإمامين الكاظمين موسى الكاظم ومحمد الجواد (عَلَيهِما السَّلَامُ)، وقد توفرت فرصة طيبة لفتح فرع بسيط في هذه المدينة المقدسة فباشر بالدرس في ربيع الثاني من (سنة 1431 ه/ 2010م) وفي المرحلة التمهيدية وبنحو ضيق بحسب طبيعة المكان المتوفر.
تتميز الحوزة بأنها مفتوحة للجميع ولكن الكثير من الراغبين في تعلم علوم آل محمد (عَلَيهِم السَّلَامُ) تمنعهم مشاغل الحياة عن الولوج في هذا الباب الشريف ولتوفير فرصة مناسبة لهذه الشريحة المباركة تقرر تنظيم دوام مسائي لا يشترط فيه التفرغ للدراسة الحوزوية ولكنه يسير بنفس نظام المدرسة وشروطها.
ص: 496
1. حصول المتقدم على شهادة الدراسة المتوسطة.
2. ان لا ينقص عمر المتقدم عن (17) عاما ولا يزيد عن (30) عاما لخريج المتوسطة ويزاد العمر لكل مرحلة دراسية أكاديمية بمقدار أدائها بلا رسوب.
3. أن ينجح في المقابلة الخاصة المناسبة للمرحلة المتقدم اليها.
4. أن يلتزم بكافة أنظمة وتعليمات المدرسة.
بعد توسع المدرسة وتنظيم علاقاتها دعت الحاجة إلى ضرورة إنشاء مركز فيها يواكب حركة العصر ومتطلباته ويسعى إلى توفير حركة علمية وثقافية مستقبلية متطورة.
فأعلن عن فتح مركز دار الحكمة للدراسات الإسلامية في المولد النبوي الشريف ابتداء من (سنة 1429ه/ 2010م) وقد قام المركز بأعمال عدة مهمة منها :
- الإشراف على موقع المدرسة (www.darhikma.net)
- إصدار بعض النشرات مختلفة الأحجام كمجلة ( غدير الحكمة) و(طرائف الحكمة) والملف الأسبوعى ولفترات متعددة في المناسبات الدينية.
- إصدار مجموعة من الكتب منها :
1.كيفية كتابة البحث.
2. المعين في الحج.
3. المنهجية العلمية للبحث العلمي.
ص: 497
4. كيف تبرمج وقتك
5. السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) سيرة ومسيرة.
6. مودة القربى.
7. المعين في العمرة.
8. الحجاب هوية المرأة المسلمة.
9. الناسخ والمنسوخ
- إقامة علاقات واسعة مع بعض الجامعات الأكاديمية.
- إقامة ثلاث دورات نخبوية للأساتذة الجامعيين حضرها عشرات الأساتذة رؤساء جامعات وعمداء كليات ومدراء.
- الإشراف على مئات البحوث الحوزوية وتقييمها.
- إصدار منشور اسبوعي ثقافي إسلامي.
- طبع المناهج الحوزوية لكافة المراحل الدراسية.
- إقامة علاقات مع المؤسسات الثقافية الحوزوية.
- استضافة الشخصيات الحوزوية والأكاديمية.
ص: 498
ت المادة الدراسية الحصص في الفصل الدراسي
1الوجيز في (العبادات والمعاملات) / الفقه 75
2النحو الواضح (3 اجزاء) / اللغة العربية 75
3خلاصة المنطق / علم المنطق 45
4قواعد التجويد (مع حفظ جزء عم ) / علوم القرآن 30
5دروس فى العقيدة / العقائد 45
6مرآة الرشاد / علم الأخلاق 30
7المطالعة والاملاء / اللغة العربية 75
الفصل الأول:
ت المادة الدراسية الحصص في الفصل الدراسي
1منهاج الصالحين / الفقه 75
2المنطق 75
3قطر الندى وبل الصدى / اللغة العربية 75
4عقائد الامامية / العقائد 45
5منية المريد / علم الأخلاق 30
6الاملاء الفريد + تفسير ج 29 من القرآن الكريم 75
ص: 499
الفصل الثاني
تالمادة الدراسية الحصص في الفصل الدراسي
1العبادات / الفقه 75
2قطر الندى قواعد اللغة العربية 75
3المنطق 75
4العبادات / الفقه 75
5التصريف / الصرف 45
6الحاسبات كومبيوتر 30
الفصل الأول:
ت المادة الدراسية الحصص في الفصل الدراسي
1المعاملات / الفقه 75
2الالفية / النحو العربي 75
3حاشية ملا عبد اللّه / المنطق 75
4البلاغة العربية 60
5التفسير ج28 15
الفصل الثاني:
تالمادة الدراسية الحصص في الفصل الدراسي
1المعاملات / الفقه 75
2الالفية / النحو العربي 75
3الباب الحادي عشر / عقائد، والحلقة الأولى/ أصول الفقه 75
4المعاملات / الفقه 75
ص: 500
الفصل الأول:
تالمادة الدراسية الحصص في الفصل الدراسى
1اللمعة الدمشقية الفقه 75
2أصول الفقه 75
3مغنى اللبيب / العربية 75
4المختصر النافع / فقه 75
الفصل الثاني:
تالمادة الدراسية الحصص في الفصل الدراسي
1اللمعة الدمشقية الفقه 75
2أصول الفقه 75
3مغنى اللبيب / العربية 75
4المختصر النافع / فقه 75
الفصل الأول:
تالمادة الدراسية الحصص في الفصل الدراسي
1اللمعة الدمشقية الفقه 75
2أصول الفقه 75
3المختصر النافع 75
4أصول الفقه 30
ص: 501
الفصل الثاني:
تالمادة الدراسية الحصص في الفصل الدراسي
1أصول الفقه 75
2اللمعة الدمشقية / ج 2/ الفقه 75
3بداية الحكمة الفلسفة 75
4علوم القرآن
المعاملات من كتاب اللمعة الدمشقية / الفقه
المكاسب / الفقه
الكفاية / أصول الفقه
دروس في علم الأصول / الحلقة الثالثة.
فرائد الأصول أو الرسائل / أصول الفقه.
(ينظر الملحق الثامن والعشرون)
ص: 502
أسست مدرسة دار الحكمة للعلوم النسوية أربعة صفوف دراسية عام 2007م، ضمن أربعة مراحل مسبوقة بمرحلة تمهيدية ضمن إطار مرحلة المقدمات، وفق مخطط يتضمن دخولها لمرحلة السطوح خلال أربع أو خمس سنوات
يتكون الكادر التدريسي في بداية ( عام 2007م / 1428ه) من (7) مدرسات ومدرسين اثنين على أن يزاد العدد متى استدعت الحاجة لذلك.
في المدرسة بداية عام 2007م / 1428ه ) (120) طالبة يدرسن مرحلة المقدمات ضمن أربعة صفوف بواقع صف لكل مرحلة، وقد بلغ عدد طالبات كل صف منها (30) طالبة تتعهد مدرسة دار الحكمة بنقلهن من المدرسة واليها يوميا.
أما في العالم الدراسي (2010-2011م / 1431 -1432ه) فقد توسعت المدرسة فضمت إلى مرحلتها الأولى مرحلة ثانية، وهي مرحلة السطوح الدنيا والسطوح العالية بدءا من المرحلة الخامسة حسب نظام المدرسة إلى المرحلة السابعة، حيث مرحلة الدراسات التخصصية في الفقه والأصول.
يتكون الهيكل الإداري لمدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية القسم النسوي مما يأتي:
يقوم بالإشراف العام على المدرسة في جميع جوانبها وخاصة العلمي والتربوي والإداري، وإقراره للسياسات العامة في مختلف الجوانب المتعلقة بالمدرسة.
ص: 503
1. اقتراح السياسات العلمية العامة.
2. تنسيق المناهج العلمية والدراسية.
3. اختيار الكادر العلمي التدريسي.
4. متابعة كافة الشؤون العلمية للمدرسة (الخطة اليومية، والسنوية، قدرة الكادر التدريسي العلمية، الامتحانات......الخ).
يتكون الكادر الإداري من مديرة ومعاونة لها ويتولى متابعة الشؤون الإدارية للمدرسة وتطبيق ضوابط اللجنة العلمية المشرفة.
وتعقد في المدرسة ندوة أسبوعية لطالبات المدرسة الهدف منها تربية وتطوير مهارات الطالبات في الجوانب العلمية في البحث والكتابة وتطوير القدرات الذاتية لهن حيث يتم في هذه الندوة: استضافة شخصية علمية لإلقاء محاضرات في مختلف الجوانب في حين يخصص الجزء الآخر من الندوة لمناقشة مختلف جوانب المعرفة بمساهمة جميع الطالبات وتصدر كل شعبة نشرة جدارية شهرية، تتابع وتقيم من قبل لجنة خاصة بتقييم هذه النشرات.
وفي المدرسة أيضا مكتبة مدرسية تحتوي على عدد كبير من الكتب وخاصة الكتب التي تحتاجها الطالبة في مجال دراستها، وهناك استمارات تحدد نسبة المطالعات في كل شعبة وفي كل الشعب والعناوين ذات الأهمية للطالبات.
أما المنهج الدراسي المعمول به حاليا فيتضمن (22) درسا للمرحلة الواحدة أسبوعيا، أي بواقع (4) دروس يومياً لستة ايام في الأسبوع موزعا على مواد دراسية
ص: 504
ينظر إليها بلحاظين :
- دروس أساسية تعطى الاهتمام الكامل في المراحل كافة من حيث الجدية في إكمال المناهج والقدرة العالية في التدريس وبذل الوسع في البحث والتمحيص وهي مواد من أمثال علوم الفقه واللغة والمنطق وما شابه في هذه المرحلة.
- ودروس مكملة لا يكون الضغط فيها على الطالب بمستوى الدروس الأساسية كالسيرة والتفسير وما شابهها.
أما في المرحلة الثالثة والرابعة فيولي المنهج الدراسي لعلم الأخلاق اهتماما خاصا، وذلك بأن يؤخذ درس الأخلاق بالصورة التالية:
يبتدأ المنهج بروايات باب الصحبة والعشرة، ثم روايات باب جهاد النفس من كتاب (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ثم يثني بالكلمات القصار من نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) حيث تقوم أحدى المدرسات الفاضلات من المعروفات بدماثة الأخلاق بقراءة رواية واحدة يومياً وبيان أهم مضامينها بما لا يتجاوز خمس دقائق من الدرس، فيكون طلاب المرحلة الثالثة والرابعة قد استعرضوا جميع هذه الروايات.
كما تطالب الطالبة بتقديم بحث مبسط في الأخلاق عوضاً عن الامتحان وتعطى الدرجة على البحث في نهاية العام الدراسي.
و تشجع المدرسة الطالبة التي ترغب ببذل جهد إضافي في الدروس من خلال توفير الأساتذة لهن بعد الظهر.
ويتيح المنهج المتبع في المدرسة دخول الطالبة في أي مرحلة بشرط الامتحان والنجاح بالمراحل السابقة.
ص: 505
كما يلزم المنهج المتبع في المدرسة الكادر التدريسي بتقديم خطة سنوية بحسب المادة المكلف بتدريسها موضحاً فيها المواد والحصص والمحاضرات بحسب اليوم والأسبوع والشهر وتحفظ نسخة من هذه الخطط عند الإدارة لمتابعتها بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية المشرفة.
وفي المدرسة مراحل دراسية متسلسلة تبدأ بالتمهيدي وتنتهي بالمرحلة السابعة التخصصية وفق المنهج التالي لكل مرحلة دراسية :
المادة الدراسية المادة الدراسية الحصص
الفقه الوجيز 5
العقائد عقائد الإمامية 4
المنطق خلاصة المنطق4
النحو التحفة السنية 4
التلاوة سلسلة النور 3
المادة الدراسية الكتاب المقرر الحصص
الفقه المسائل المنتخبة (العبادات) 5
العقائد بداية المعرفة 4
المنطق منطق المظفرج 1 5
ص: 506
النحو قطر الندى (ج 1 + ج 2) 5
الصرف كتاب التصريف2
الأخلاق مرآة الرشاد 1
المادة الدراسية المادة الدراسية الحصص
الفقه المسائل المنتخبة (المعاملات) 5
العقائد تلخيص الإلهيات 5
المنطق منطق المظفر ج2 5
النحو الفية ابن مالك ج15
الأخلاق مرآة الرشاد 1
المادة الدراسية الكتاب المقرر الحصص
الفقه منهاج الصالحين /العبادات 5
العقائدتلخيص الإلهيات 5
النحو ألفية ابن مالك ج 2 5
البلاغة البلاغة الواضحة 4
ص: 507
المادة الدراسية الكتاب المقرر الحصص
الفقه منهاج الصالحين / المعاملات (ج2، ج 3 ) 5
العقائد الباب الحادي عشر 5
الأصول الحلقة الأولى، الثانية 5
الدراية دروس في علم الدراية 2
المادة الدراسية الكتاب المقرر الحصص
الفقه اللمعة / كتاب الطهارة ما عدا ( طهارة ماء البئر، أحكام الميت) 5
العقائد محاضرات منبرية + الباب الحادي عشر 2
الأصول الحلقة الثانية 5
الرجال دروس في علم الرجال / للشيخ السبحاني 5
التفسير سورة البقرة 2
ص: 508
مدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية
المادة الدراسية الكتاب المقرر الحصص
الأصول الحلقة الثالثة 6
المكاسب المحرمة الجزء الاول والثاني 6
أما نظام العام الدراسي للمدرسة فقد تحدد بما يأتي:
أولاً :
1. يبتدئ العام الدراسي في اليوم الأول من شهر أيلول (9/1) من كل عام.
2. تبدأ الامتحانات نصف السنوية في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني والى الثلاثين منه بواقع أسبوع واحد فقط (1/24 - 1/30).
3. تبدأ العطلة نصف السنوية في اليوم الأول من شهر شباط والى اليوم السابع منه بواقع سبعة أيام فقط (2/1-2/7).
4. ينتهي العام الدراسي في الثلاثين من شهر حزيران (6/30).
5. تبدأ الامتحانات النهائية في الأول من شهر تموز وتنتهي في الرابع عشر منه، فتكون مدتها أربعة عشر يوماً فقط (7/1 - 7/14).
6. تبدأ العطلة السنوية (الصيفية) في الخامس عشر من شهر تموز وتنتهي الثلاثين من شهر،آب فتكون مدتها خمسة وأربعين يوماً (7/15 - 8/30).
7. تبدأ امتحانات الدور الثاني في الخامس عشر من شهر آب وتنتهي في الحادي والعشرين منه، فتكون مدتها سبعة أيام فقط (1/15 - 21/ 8).
ص: 509
وبهذا ينقسم العام الدراسي إلى فصلين :
الفصل الأول : ويبدأ في الأول من شهر أيلول وينتهي في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني فيكون مدته أربعة اشهر وثلاثة أسابيع (1/249/1).
الفصل الثاني: ويبدأ من الثامن من شهر شباط وينتهي في الثلاثين من حزيران، فيكون مدته أربعة اشهر وثلاثة أسابيع أيضاً (6/302/8).
فيكون مجموع الفصلين تسعة اشهر ونصف وهو مجموع الأيام الدراسية للعام الدراسي، وبإضافة المدة الامتحانية لنصف السنة ونهاية السنة ومقدارها ثلاثة أسابيع فيكون مجموع أيام الدوام الدراسي للعام الدراسي: عشرة أشهر وأسبوع.
ثانياً :
1. يفتح باب التسجيل والقبول ابتداء من 7/1 ولمدة شهر واحد، ينتهي في 1/ 8، على ان تجري المقابلات ويحسم القبول في مدة اقصاها 9/1.
2. القيام بالإعلان عن التسجيل والقبول وإجراء المقابلات وما يجري مجرى ذلك من حين الانتهاء من الامتحانات النهائية.
3. استمرار الكادر الإداري والتدريسي بالدوام في العطلة الصيفية بما يضمن سير عملية التسجيل والقبول والإعلان وما شابه.
وفيما يأتي خلاصة للتوقيتات المتقدمة:
1/ 9ابتداء العام الدراسي
24/ 301/ 1امتحانات نصف السنة
1/ 72 /2عطلة نصف السنة
ص: 510
30/ 6نهاية العام الدراسي
1/ 147 / 7الامتحانات النهائية
15/ 7- 30 / 8العطل الصيفية
15 /8- 21/ 8الدور الثاني
ونظرا للاقبال على المدرسة فقد ارتفع عدد الطالبات في العام الدراسي (2010 - 2011م) / (1431 - 1432 ه ) إلى (110) طالبات بينهن (21) طالبة في مرحلة الدراسة العليا.
وتبين الإحصائية اللاحقة توزيعهن على المراحل الدراسية وفق الجدول التالي:
ت المرحلة الدراسية عدد الطالبات.
1التمهيدية 30
2الأولى / مقدمات 25
3الثانية / مقدمات 17
4الثالثة / مقدمات 6
5الرابعة / مقدمات 4
6الخامسة / سطوح أولية 7
7السادسة / سطوح أولية لا يوجد
8الدراسات العليا التخصصية (الأصول والفقه) 21
ص: 511
المجموع الكلي 110
ونتيجة لهذا التوسع فقد ارتفع ملاك المدرسة في العام الدراسي (2010 - 2011م) / (1431 - 1432ه) إلى (27) مدرسة محاضرة ومدرس محاضر توزعت دروسهم ومحاضراتهم وفق الجدول التالي :
ت المادة عدد المدرسات والمحاضرين
1الفقه 7
2المنطق 2
3العقائد 5
4الأصول 3
5النحو والصرف 3
6البلاغة 1
7الدراية 1
8علم الرجال 1
9الخطابة 1
10التفسير 2
11الأخلاق 1
المجموع الكلي 27
ص: 512
هذا وقد دأبت المدرسة على تقديم دعم مادي محدود للطالبات أسوة لما هو معمول به في الحوزات العلمية ويزداد هذا الدعم كلما تقدمت المرحلة الدراسية للطالبة وكما هو مبين في الجدول التالي:
1المرحلة التمهيدية 15 ألف دينار
2المرحلة الأولى 25 ألف دينار
3المرحلة الثانية 30 ألف دينار
4المرحلة الثالثة 40 ألف دينار
5المرحلة الرابعة 50 ألف دينار
6المرحلة الخامسة 60 ألف دينار
7المرحلة السادسة 70 ألف دينار
8مرحلة الدراسات العليا التخصصية 150 ألف دينار
أما المتعففات من الطالبات فيقدم لكل منهن مبلغ قدره (65) ألف دينار، عسى أن يساعدهن هذا المبلغ الضيئل المتيسر على تحمل مشاق الحياة اليومية المكلفة.
وقد دأبت المدرسة على الاهتمام الملحوظ بالاستمارات الواردة في النظام لتطبيق الضوابط الإدارية ومن أهمها:
1. استمارة رصد النشاط اليومي للطالبات.
2. استمارة إحصائية الغيابات اليومية للعام الدراسي.
3. استمارة برنامج الندوة الأسبوعية.
4. استمارة درجات العام الدراسي.
ص: 513
5. استمارة تقييم الطالبات في المقابلة للمتقدمات للمدرسة.
6. استمارة تعريف الطالبة.
7. استمارة القبول في المدرسة واستمارة القبول التمهيدي.
8. استمارة تقييم الطالبة (سري).
9. استمارة تقييم الوضع العام للمدرسة والأساتذة.
10. استمارة الإحصاء الأسبوعي لمكتبة المدرسة.
11. استمارة الحضور والغياب اليومي للأسبوع.
12. استمارة قائمة المحاضرات للمدرسين والمدرسات.
13. استمارة التقييم الشخصي للنشرات الجدارية.
14. استمارة التقييم العام للنشرات الجدارية.
15. استمارة تعريف موظفات المدرسة.
16. استمارة مخصصات وراتب المدرسات والمدرسين.
17. استمارة مخصصات الطالبات.
18. استمارة رواتب ومخصصات العاملين.
19. جميع استمارات المصروفات ذات العلاقة بالمدرسة.
20. جدول مصروفات المدرسة للعام الدراسي.
ويتم تعديل هذه الاستمارات بما ينسجم مع الواقع الجديد كلما استجدت الحاجة لذلك.
ص: 514
بعد سقوط النظام الصدامي البائد في (عام 2003م / 1424ه) ولضرورة الحفاظ على المبادئ والقيم الإسلامية والدينية وغرسها في نفوس الناشئة، خصوصا الشريحة النسوية منها تلك التي غيبت طيلة فترة حكم الطاغوت وحجبت عن انتهال العلوم والمعارف الإسلامية لمدة تزيد على ربع قرن حيث كان التزود بعلوم الحوزة العلمية حلما يراود الكثيرات منهن.
ومن أجل توثيق الصلة وترسيخها بالمرجعية الدينية والمساهمة بملئ الفراغ الديني لدى المرأة وحثها على التوعية والاجتهاد في تحصيل أمور دينها وما يخصها من علم الفقه والعقائد كركيزة أولى تبنى عليها أركان عقيدتها ومبادئها وفكرها القويم المتمثل بمذهب أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) وفكر أبنائها على كافة الأصعدة، لذا ارتأت النخبة من رجالات العلم والمعرفة السعي في هذا المضمار خدمة للعلم والدين.
لقد كانت البداية الأولى للمشروع متواضعة حيث تم استزراع البذرة الأولى بحسينية لإحدى النساء الفاضلات فكانت الخلية الأولى لها من كادر متواضع من المربيات الفاضلات اللاتي ناضلن سراً في زمان الظلم والجور وحصلن على المعلومة
ص: 515
الحوزوية من خلال جهاد متواصل وبظروف غاية في الصعوبة حيث كان همّهن أن يستقطبن أكثر عدد من النساء للقيام بدورهن الفاعل والمصلح والمربي.
لقد هيأ اللّه للمدرسة سماحة السيد أحمد الصافي (حفظه اللّه) الذي بادر مشكوراً بفتح هذه المدرسة حيث انبثق نور الهداية والمعرفة للكادر النسوي الحوزوي بأرجاء حسينية في حي المثنى في الشهر التاسع من سنة 2003م المصادف ليوم 23 جمادي الثانية عام 1424ه، ثم انتقلت المدرسة نتيجة للظروف الصعبة إلى بناية كانت روضة للأطفال في حي السعد أحد أحياء مدينة النجف الأشرف حيث استطاعت إدارة المدرسة أن تستحصل موافقة إدارة الروضة على أن تنتقل اليها بما لا يتعارض مع دوامها الصباحي وذلك بأن تستغل المدرسة الوقت المسائي للبناية لدوامها ونشاطاتها، وبعدها انتقلت المدرسة إلى أحد أحياء المدينة القديمة في المنطقة المسماة بالجديدة الثانية فاستقرت فيها مدة سنة كاملة ثم اضطرت نتيجة لصعوبة المواصلات داخل المدينة القديمة إلى أن تنتقل في (1 /11 / 2006م الموافق لسنة 1427ه) إلى حي الغدير في شارع كلية الآداب يحدو خطواتها العزم والإسراع بالمواصلة والسعي نحو الأفضل لتعميم الفائدة للجميع بعون اللّه تعالى.
لمدرسة دار العلم نظام للقبول يشتمل على الشروط التالية :
1. أن تكون الطالبة على قدر من الالتزام الديني والخلق الأدبي والتربية الفاضلة.
2. أن تمتلك الطالبة تحصيلا أكاديميا يصل إلى المتوسط فما فوق.
3. تفضل من الطالبات من لها معرفة وإلمام بالدراسة الحوزوية والعلوم الإسلامية. سابقاً
ص: 516
أما المستمسكات المطلوبة من الطالبة فهي إضافة إلى الجنسية، وشهادة الجنسية، تزكية من كفيل مضمون يرجع اليه عند الحاجة
لمدرسة دار العلم منهج تدريسي يتم التركيز فيه على العلوم التالية : الفقه العقائد، المنطق، النحو والصرف، علوم القرآن أحكام التلاوة، علم الأخلاق ولكل من هذهالعلوم كتبه المقررة كما يأتي:
أ. بالنسبة لمادة الفقه تعتمد المدرسة في تدريسه الكتب التالية:
ب. المسائل المنتخبة للسيد السيستاني (دام ظلّه) الجزء الخاص بالعبادات.
منهاج الصالحين للسيد السيستاني (دام ظلّه) الجزء الخاص بالعبادات، مع بعض الموضوعات المنتقاة من قسم المعاملات
أما بالنسبة لمادة العقائد فقد قررت إدارة المدرسة أن تعتمد الكتب التالية:
أ. بداية المعرفة للسيد حسن مكي العاملي.
ب. النافع في شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري.
وفي مادة المنطق قررت المدرسة أن تعتمد على كتاب المنطق للشيخ محمد رضا المظفر (قدّس سِرُّه).
وفي مادة النحو والصرف تدرس المدرسة الكتب التالية :
أ. التحفة السنية في شرح الأجرومية بشرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد.
ب. قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري
ص: 517
ج. شذى العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي.
أما درس الأخلاق فقد قررت المدرسة أن تعتمد كتاب منية المريد لزين الدين بن علي بن أحمد العاملي.
وفي درس القرآن وتعليم أحكام التلاوة تعتمد المدرسة على كتاب ما يختاره الأستاذ لطلابه بالاتفاق مع الإدارة.
هذا وتعتمد أسلوب إتمام الكتب وفق هذه مراحلها الدراسية وهي قابلة للزيادة والتطوير حسب التقدم بدراسة المواد.
للمدرسة نظام حضور للطالبات تلزم به طالباتها مقسم على أربعة ايام اسبوعيا هي (الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء). من كل أسبوع حيث يبدأ الدوام الفعلي من الساعة الثانية عصراً وحتى الرابعة والنصف ولها نظام خاص للغيابات تجيز فيه المدرسة للطالبة أن تحصل على إجازة لظرف خاص تقدره إدارة المدرسة فإذا غابت الطالبة شهرا من دون عذر مشروع تفصل من المدرسة.
هذا وتبدأ السنة الدراسية في الشهر العاشر من كل عام ميلادي وتحل العطلة الصيفية في الشهر الثامن منه علاوة على الإلزام المدرسة بالتعطيل في وفيات الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) إلى جانب أسبوعين من شهر محرم الحرام في ذكرى استشهاد الإمام الحسين السبط أبي الشهداء وآله وصحبه الكرام.كما وتعطل المدرسة طيلة شهر الصيام شهر رمضان المبارك أيضا.
أما النظام الخاص بالامتحانات فيقتضي أن تكون الامتحانات مستمرة خلال أيام السنة الدراسية وهى متفاوتة بين إمتحانات يومية وفصلية ونهائية مقسمة على فصلين وتكون درجة النجاح في المدرسة (60%).
ص: 518
لقد بلغ نصاب طالبات المدرسة أول عام من افتتاح المدرسة (100) طالبة للمرحلة الأولى، ومن ثم ازداد العدد في العام الثاني بعد نجاح الطالبات للسنة الثانية فبلغ نصاب الطالبات حينها حوالي (120) طالبة بعد التسجيل الجديد للطالبات المتقدمات للتسجيل في المرحلة الأولى. وفي السنة الثالثة استحدث صف آخر وهو المرحلة الثالثة فبلغ النصاب وقتها (129) طالبة. أما في هذه السنة فقد ارتفع العدد إلى (137) طالبة مما اضطر إدارة المدرسة إلى وقف التسجيل لضيق المكان حيث أن التسجيل مرهون بسعة المكان وضيقه، وبما أن البناية الحالية لا تسع لأكثر من هذا العدد على أمل أن يتهيأ لها مكان أوسع مستقبلا إن شاء اللّه لاحتضان المزيد من الطالبات
وقد أطلقت المدرسة أسماء الصحابة الأجلاء على الصفوف تيمنا بعطائهم وتضحياتهم فس سبيل الإسلام والمسلمين، فمثلا أطلق على اسم المرحلة الرابعة اسم الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري (رضیَ اللّهُ عنهُ)، وأطلق على المرحلة الثالثة اسم الصحابي الجليل سلمان المحمدي (رضیَ اللّهُ عنهُ).
كما اطلق على المرحلة الثانية اسم الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدّس سِرُّه)، وعلى المرحلة الأولى اسم عميد المنبر الحسيني الدكتور الشيخ أحمد الوائلي (رحمه اللّه برحمته الواسعة وأدخله فسيح جناته).
أما بالنسبة إلى عدد الطالبات في كل شعبة من شعب المدرسة فهو كالآتي:
1. المرحلة الأولى (70) طالبة.
2. المرحلة الثانية (30) طالبة.
2. المرحلة الثالثة (20) طالبة.
ص: 519
4. المرحلة الرابعة (17) طالبة.
ملاك المدرسة
1. مديرة المدرسة.
2. معاونة المدرسة.
3. المدرسات وعددهن (11) مدرسة موزعات على المواد التالية:
أ. الفقه الإسلامي (3) مدرسات.
ب. علم المنطق (2) مدرسة.
ج. النحو والصرف (2) مدرسة.
د. العقائد (2) مدرسة.
ه. أحكام التلاوة. (1) مدرسة.
و. علم الأخلاق (1) مدرسة.
أما مسؤولية الإدارة فقد أناط النظام بمديرة المدرسة مسؤولية مباشرة أمام التزامات المدرسة ككل من إرشاد الطالبات وحل مشاكلهن والتعاون معهن كما تتحمل المديرة كافة أمور الصرف وتهيئة كافة مستلزمات المدرسة من قرطاسية وأشياء أخرى حيث يتولى الصرف عليها سماحة السيد أحمد الصافي كما وتصرف الرواتب للمدرسات وفق نظام المحاضرات وتقدم الإدارة هدايا للطالبات المتفوقات مع متابعة الساهرين على حراسة المدرسة ورعايتها ومتابعة وسائط النقل المعدة لنقل الطالبات من وإلى بيوتهن ذهاباً وإياباً
ص: 520
للمدرسة نشاطات داخلية وخارجية كما يلي
الداخلية : وتشمل إقامة الإحتفالات داخل المدرسة بمناسبة مواليد الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) وإقامة المحاضرات ومجالس العزاء بوفيات الأئمة الأطهار (عَلَيهِم السَّلَامُ) إحياء لأمرهم كما وتقيم أحتفالات أخرى للشخصيات الإسلامية والمفكرين والعلماء تأبيناً لهم بعد وفاتهم أو تعرفياً بما قاموا به من جهود في خدمة المبدأ والفكر والعقيدة كما أنها تقيم احتفالات للطالبات المتفوقات إضافة إلى حفلة تكريم كبيرة للناجحات إشعارا من المدرسة بالاهتمام بهن ودفعهن إلى مزيد من النجاحات في المستقبل.
الخارجية : وغالبا ما تكون محدودة حالياً نتيجة للظرف الأمني الصعب الذي تمر به البلاد وخاصة بالنسبة للنساء ومع ذلك فقد قامت المدرسة بسفرة لزيارة الإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) شملت كادر المدرسة بأجمعه كما وزارت المدرسة قبر الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كربلاء المقدسة وشاركت طلابها طالبات المدارس الأخرى في الاحتفالات التي تقام فيها إضافة إلى أنها قامت بمسيرة سلمية في ذكرى تهديم قبة الإمامين العسكريين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) إحياءً للذكرى وتأكيداً للمظلومية كما هيأت المدرسة لملاكها زيارة المراجع العظام في النجف الأشرف للتزود بالتوجيهات اللازمة.
هذا وتستقبل المدرسة بين آونة وأخرى وفود المدارس النسوية المشابهة لها تأكيداً لأواصر المعرفة وتبادل الخبرات في خدمة العلم والعلماء.
ص: 521
ص: 522
الهيئة العلمية لمؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي، ومؤسسة المصطفى للإرشاد والتوعية الدينية أنموذجا
ص: 523
ص: 524
تحدثت فيما سبق عن واجبات أساتذة وطلاب الحوزة العلمية بشكل عام ومنها الحوزة العلمية في النجف الأشرف، فكان مما ذكرت التبليغ والتواصل والإرشاد والتوعية والتقويم وأهميتها في مجال عمل الحوزوي ومسؤولياته.
ولقد تجلى هذا الواجب الملقى على عاتق المؤمنين كل المؤمنين وبخاصة أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف بشكل واضح بعد سقوط النظام البائد، حيث بان بشكل جلي مدى حاجة العراقيين إلى التبليغ والإرشاد والتوعية من خلال شرح وتوضيح عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه وتبيان تاريخ وسيرة حياة النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) والأئمة المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ) وذكر أحوال وسير أصحابهم وحوارييهم وخاصتهم ثم المرجعية الدينية ومراجعها العظام وحوزتها العلمية وما إلى ذلك من شؤونها وأشجانها، والى كل ما يمت إلى الإسلام والتشيع بصلة.
ولذا فقد نشأت الحاجة الماسة إلى تطوير العملية التبليغية والإرشادية وتنظيم آلياتها وإعداد مبليغها ودراسة الخطط الموصلة إلى هذا الهدف كي تقوم الحوزة بواجبها خير قيام، وهو ما نهضت به جهات عديدة، منها الهيئة العلمية لمؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي في النجف الأشرف، التي تعد مؤسستها من كبرى مؤسسات التبليغ العراق حيث حازت على المقعد الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني في الأمم المتحدة (أن. جي. أو)، ومن هذه المؤسسات التبليغية الإرشادية مؤسسة المصطفى للإرشاد والتوعية الدينية وغيرهما عدد لا بأس به، لا يسعني المجال
ص: 525
للحديث عنها في هذه الطبعة عسى أن أوفق للوقوف عليها لاحقا.
وإذ كنت قد تحدثت عن مؤسسة شهيد المحراب في الطبعة الأولى من هذا الكتاب، وخاصة وهي تمر هذه السنة بمرحلة دراسة التجربة وتقييمها وتشخيص إيجابيات العمل وسلبياته، فسأتحدث في هذه الطبعة عن هيئتها العلمية التي أنشأتها من أجل التثبت من دقة موائمة نشاطات المؤسسة مع الأحكام الشرعية في مسعى تقرر أن تمثل فيه الهيئة العلمية للمؤسسة الدراية الفقهية والعمق الحوزوي ضمن اطار مؤسسي لتشيكل حلقة الوصل بين تراث أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) والواقع الاجتماعي والاكاديمي، وبالتالي تقدم قراءة تعكس الواقع السليم لمنهج الاعتدال المحمدي الاصيل، لذا فقد خطط لها لتتولى من خلال اقسامها المتعددة تجسير الاطروحات المختلفة بين المرجعية الدينية وفضلاء الحوزة العلمية من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني، علاوة على المؤسسات الاكاديمية والتشكيلات الاجتماعية المختلفة من جهة أخرى.
كما سأتحدث عن مؤسسة المصطفى التي ركزت على موضوع الإرشاد والتوعية الدينية المباشرة غالبا والمبسطة دائما من أجل الإجابة عن الأسئلة وإيضاح أجوبتها للمؤمنين السائلين.
وذلك في مبحثين مبتدئا المبحث الأول منهما المخصص للهيئة العلمية لمؤسسة شهيد المحراب متناولا إياها في مطلبين.
ص: 526
وفيه مطلبان :
تتكون الهيئة العلمية من :-
1. نشاطات السيد رئيس الهيئة العلمية وتتقاسمها
أ. المتابعات الداخلية وتتم من خلال الاشراف على جميع نشاطات اقسام الهيئة العلمية واتخاذ القرارات اللازمة و التنسيق المتواصل مع الأمانة العامة في الإشراف على الجوانب العلمية.
ب. الزيارات والاجتماعات واللقاءات وتتركز على:
* الزيارات المتواصلة لمراجع الدين العظام (دام ظلهم).
* الاجتماعات مع سماحة السيد الامين العام لمؤسسة شهيد المحراب (قدّس سِرُّه).
* إعداد جدول للقاءات سماحة السيد الامين العام لمؤسسة شهيد المحراب مع فضلاء الحوزة العلمية.
ص: 527
* العديد من اللقاءات مع فضلاء الحوزة العلمية داخل و خارج الهيئة العلمية.
* عقد لقاءات مع شخصيات سياسية ووطنية وعلمية واكاديمية وشخصيات مثقفة.
* المشاركة في المهرجانات والندوات المختلفة.
*تقديم الاستشارة لطلاب رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا في الجامعات.
* الزيارات خارج محافظة النجف الأشرف وتضمن:
- لقاءات مع بعض رؤساء وأساتذة وطلبة الجامعات.
- المشاركة في المواكب الحسينية.
* زیارات خارج جمهورية العراق
ج. الإشراف العلمي على مدرسة دار الحكمة / القسم النسوي، ومعهدي الإمام السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه) في بابل والديوانية.
2. نشاطات الهيئة العلمية وتضم:
أ. النشاطات التي تقام على قاعة أبي طالب العلمية (سلام اللّه عليه)
* إقامة مجموعة من ندوات لموضوع (مناهضة العنف ضد المرأة ).
* إقامة سلسة من الندوات المختلفة حول مسائل تخص الوضع الإسلامي العام في مرافق الدولة المختلفة.
* مناقشة بعض رسائل الماجستير.
ص: 528
* إقامة ندوات استذكار لبعض المفكرين والناشطين في حقول المعرفة الإسلامية والتبليغ.
* استضافة بعض الخطباء لتدارس خصوصياتهم الخطابية.
* محاضرات لبعض أساتذه الحوزة العلمية على طلبة الجامعات العراقية.
* إقامة الملتقى الرمضاني الثالث للسجناء السياسيين العراقيين.
ب. إقامة دورات تعليمية وتدريبية متنوعة من أمثال:
* دورة حول منهجية البحث العلمي وتعلم آليات الكتابة المنهجية والتأليف: مجموعة محاضرات للأستاذ الدكتور السيد عبد الهادي الحكيم.
* دورة لتعليم اللغة الانكليزية.
* دورة عن الإعلام تتضمن كتابة الخبر والتقارير والصحيفة وغيرها مع فن التصوير
ج. نشاطات أقامتها الهيئة العلمية للتنسيق بين الحوزة العلمية والجامعة.
للهيئة العلمية قسم خاص بالاصدارات له شعبتان هما :
شعبة تقويم الاصدارات: ووظيفتها تقييم جميع الكتب والبحوث والمجلات والمقالات التي ترد إلى الهيئة العلمية
1. من الدوائر التابعة لمؤسسة شهيد المحراب (قدّس سِرُّه) أو من المراكز والمؤسسات الدينية والعليمة من خارج المؤسسة أو من المؤلفين أنفسهم مقسما إياها إلى
ص: 529
فئات ثلاث.
الفئة (أ) : وهو التقييم الدقيق للاصدارات علمياً وفكريا وابداء الملحوظات بشأنها اجمالا وتفصيلا ويعنى غالبا بالاصدارات قيد الطبع والاصدارات العلمية التخصصية.
الفئة (ب): وهو التقييم الذي يحرز من خلاله عدم وجود أخطاء علمية أو ادبية أو فنية فاحشة.
الفئة (ج) : وهو التقييم الذي يحرز من خلاله أن الإصدار ليس فيه خطأ علمي فاحش، ويعنى غالبا بالصحف وكتب الأطفال ونحو ذلك.
وبموجب ذلك تم تقييمه ما يلي خلال خمسة عشر شهرا
159 كتابا و 145 صحيفة ومجلة، و 142، و وحوالي 70 كراسا وقرصا ليزريا.
كما بلغت مجموع الصفحات المقيمة خلال خمسة عشر شهرا : 80000
2 - شعبة تطوير الاصدارات :
يتكون القسم من مجموعة من فضلاء الحوزة العلمية ويتناول:
1 - العمل البحثي لفضلاء القسم ويعنى بإعداد البحوث من قبيل:
أ- حرمة سفك الدم.
ب- الديمقراطية.
ج- الوطن والوطنية من منظور شرعي.
د- الانتخابات والتشريع.
ص: 530
ه - المرجعية الدينية.
و – مشروع بحث الرؤية الإسلامية للمرأة وقضاياها (القوامة) أنموذجا.
ز - الإعداد لمشروع قراءة في قوانين القضاء العراقي من الناحية الشرعية.
ح- مناهضة العنف ضد المرأة.
ط - الحجاب.
خامساً : قسم المناهج ويتولى مراجعة وتقييم المناهج الدراسية الحديثة للدراسات الإسلامية للمعاهد التي تشرف عليها مؤسسة شهيد المحراب (قدّس سِرُّه)، وكذلك مراجعة المناهج الدراسية المقررات (التربية الإسلامية) والتاريخ للمراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وتقييمها وتعيين مواطن الخلل فيها بما ينسجم مع الرؤية الإسلامية الصحيحة. إضافة إلى كتابة المناهج الدراسية للدورات الصيفية التي تقيمها مؤسسة شهيد المحراب (قدّس سِرُّه).
تكونت شعبة إعداد المناهج من بعض فضلاء الحوزة العلمية وأساتذة أكاديميين ومشرفين علميين وأنيطت بها مهمة إعداد مناهج للدورات الصيفية التي تقيمها مؤسسة شهيد المحراب للطلاب على اختلاف مراحلهم الدراسية في أنحاء العراق خلال العطلة الصيفية. وقد انجزت خمسة عشر منهجاً للدورات الصيفية وكالآتي:
أ. خمسة مناهج لطلبة المرحلة الابتدائية وهي:
1. الفقه للبنين.
2. الفقه للبنات.
ص: 531
3. العقائد
4. الاخلاق
5. سيرة النبي وأهل بيته الكرام.
ب. خمسة مناهج لطلبة المرحلة المتوسطة وهي:
1. الفقه للبنين.
2. الفقه للبنات.
3. العقائد
4. الاخلاق
5. سيرة النبي وأهل بيته الكرام
ج. منهجان للروضة.
خامساً : قسم العلاقات العامة هو المحور والواسطة بين الهيئة العلمية والاطراف المعنية ضمن أهداف هذه الهيئة والناشط الرئيسي لبيان اهدافها وعملها للأطراف المهتمة والتي لها صلة بها.
ويتكون أعضاء القسم من فضلاء الحوزة العلمية في النجف الأشرف ويتولى الأمور التالية:
1. الانفتاح وزرع الثقة بين الهيئة العلمية من جهة والحوزة العلمية من جهة أخرى.
ص: 532
2. الزيارات المتواصلة للفضلاء وأساتذة الحوزة العلمية لبيان نشاط الهيئة العلمية والاستفادة من آرائهم ونصائحهم لتطوير الجانب العلمي والعملي في الهيئة العلمية.
3. الزيارات المتواصلة للمؤسسات الموجودة في النجف الأشرف وبيان نشاط الهيئة العلمية وتبادل الافكار والخبرات.
4. التنسيق مع الإخوة من أصحاب الفضيلة ممن لديهم مؤسسات في المحافظات الأخرى، أو لهم نشاط تبليغي علمي وعملي.
5. الانفتاح على شرائح المجتمع الاخرى، ولاسيما الجامعات والمعاهد وتبادل الآراء وبيان دور الحوزة العلمية ومراجعها والهيئة العلمية بالخصوص في رفد الجانب العلمي.
6. متابعة الإعلام الخارجي والداخلي، ولاسيما عن طريق الانترنت للاحاطة بكل ماهو يمس بالمذهب أو بقدسية علمائه.
7. إنشاء لجنة خبراء من أصحاب الفضيلة من خارج الهيئة العلمية لرفد الجانب العلمي والعملي للهيئة.
8. إنشاء قاعدة بيانات للشيعة في أوربا، وقد تم إنجاز 3000 صفحة من هذا العمل التوثيقي المهم.
وقد انتهى من إعداد :
1 - استبيان موسع لطلاب الدورات الصيفية التي اعتادت على فتحها مؤسسة -
ص: 533
شهيد المحراب في أنحاء العراق حيث وصل أعداد طلابها وطالباتها إلى مئات الآلاف لمعرفة مدى تأثير مناهج الدورات الصيفية وفعالية عمل المبلغات وغيرها من المواضيع التي عمل عليها القسم.
2 - استبيان العنف ضد المرأة.
وهو ما سأتناوله مفصلا في المطلب التالي
ص: 534
يعد موضوع العنف ضد المرأة مشكلة عالمية أولتها المؤسسات والمنظمات الحكومية والمدنية اهتماما واسعا كما استغرق بحث هذا الملف وقتا غير قصير في أروقة الأمم المتحدة.
كما أخذ البحث فيه طابعا غير علمي تداخلت الأمور فيه فوصلت إلى حد اتهام دول العالم الثالث وخصوصا الإسلامية منها بكونها مصدرا للعنف، وعندما قامت الهيئة العلمية لمؤسسة شهيد المحراب بمشروع استبيان حول العنف ضد المرأة على المستوى الوطني في العراق فقد وضعت الحقائق والأرقام التفصيلية إمام نظر الباحث المنصف كي يحكم هو ويكوِّن بنفسه صورة عن واقع المجتمع العراقي الذي أظهر بوضوح أن أحكام وقيم ومفاهيم الإسلام لا زالت لها تأثيرها المهم على مجريات الحياة الاجتماعية اليومية، بل تشكل بوضوح أهم أعمدتها الفاعلة على صعيدي الممارسة والتطبيق للفرد والمجتمع.
والهيئة العلمية إذ تضع هذه الأرقام والمخططات الواقعية التي تم تحصيلها من خلال تشكيل لجان تخصصية عالية الكفاءة ضمت أساتذة جامعيين ومفكرين وتنفيذيين ومن خلال الفرق الميدانية الجوالة العاملة على هذا المشروع، والتي تم جدولتها وإيضاح مفاصل نتائجها في قسم الاستبيان في الهيئة العلمية، ترجو أن يستفيد منها المعنيون في الأجهزة المختلفة لمعالجة ما يمكن معالجته من خلال وضع الحلول الناجعة لها حاضرا
ص: 535
ومستقبلا، واضعة أمام القراء نقاط مشروع استبيانها التالية:
أولاً: انطلق المشروع بتاريخ 1/ 8 / 2009/ 1430ه حيث شمل الاستبيان سبع محافظات مثلت مزيجا يحكي التركيبة السكانية للمجتمع العراقي اختيرت من شمال ووسط وجنوب العراق ممثلة هذه التركيبة في المحافظات التالية: (اربيل - نينوى - كركوك - بابل - كربلاء - ذي قار – واسط) حيث قام حملة المشروع بتوزيع ثم جمع استمارة الاستبيان من خلال فرق ميدانية شملت متطوعين ومنظمات مجتمع مدني متعددة منها: (منظمة المرأة المسلمة، ودائرة شؤون المرأة في مؤسسة شهيد المحراب (قدّس سِرُّه)، والمجلس الأعلى الإسلامي القسم النسوي، وحركة سيد الشهداء القسم النسوي) وغيرها.
أما الآليات التي اتبعت لتحقيق المشروع المراد تنفيذه فهي :
بدأ التحضير للاستبيان بتاريخ (2009/7/15م) من خلال اعتماد الخطوات التالية:
* عقد اجتماع مع اللجنة المشرفة على الاستبيان وضمت السيد رئيس الهيئة العلميةمع اعضاء اللجنة د. إحسان القرشي رئيس الجامعة المستنصرية، د. عادل البغدادي، د. عقيل الخاقاني، وسماحة الشيخ عقيل الخفاجي مسؤول قسم الترجمة، ونتج عن الاجتماع الاتفاق على تنظيم استمارة استبيان وتحديد عدد النساء اللواتي يشملن بالاستبيان من محافظات العراق.
* عقد اجتماع مع الكوادر التي توزع الاستمارات، وضم مندوبات عن بعض محافظات،العراق، وهن من ضمن مؤسسات المجتمع المدني وهي (منظمة المراة المسلمة - دائرة شؤون المراة في مؤسسة شهيد المحراب - المجلس
ص: 536
الاعلى الإسلامي القسم النسوي - حركة سيد الشهداء القسم النسوي) ومن محافظات (اربيل الموصل - كركوك - بغداد - بابل - كربلاء _ النجف الأشرف _ ذي قار - ميسان – البصرة) وكانت اهم نتائج الاجتماع بیان الخطوط العامة لسير الاستبيان وتوضيح غرضه وكيفية العمل به.
* بدأت الكوادر بالعمل وتوزيع الاستمارات على النساء واكمالها وارسالها إلى الهيئة العلمية وتم استلامها بتواريخ متعددة كان آخرها بتاريخ (2010/1/12) .
* بدأت مرحلة العد والفرز لاستمارات الاستبيان وتم فيها تمييز الاستمارات الصالحة من غيرها.
* البدء بمرحلة ادخال المعلومات إلى الحاسبة على برنامج (Excel) حيث استغراق الوقت الكلي (71) يوماً من تاريخ (28/ 9/ 2009) إلى تاريخ (2010/3/13).
أولا : شمل استبيان العنف ضد المرأة سبع محافظات هي اربيل، نينوى، كركوك، بابل، كربلاء، النجف الأشرف، ذي قار، واسط والتي سوف تكون معتمدة لنتائج نهائية للعنف ضد المرأة في العراق.
ص: 537
ثانياً : - تم تحليل النتائج لكل محافظة على حدة.
أما عدد الاستمارات الموزعة على المحافظات فكان وفق الجدول رقم (1) التالي:
.jpg 538^
ثالثا - بعد وصول الاستمارات إلى قسم الاستبيان في الهيئة العلمية (آخر استمارة وصلت بتاريخ : 2/ 1 / 2010) بدأت مرحلة الفرز والتحليل لنتائج محافظة محافظة، ثم جمعت النتائج لتشمل جميع المحافظات المشمولة بالاستبيان.
رابعا : أظهرت نتائج الاستبيان ما يأتي:
1. أن النسبة العامة للعنف ضد المرأة في العراق هي : 9 ،8٪، موزعة على قسمين هما
أ. الريف بنسبة : 5،9%.
ب المدينة بنسبة : 3.
ص: 538
2. أن أنواع العنف هي:
أ. العنف الجسدي بنسبة : 1، 26%.
ب. العنف المعنوي بنسبة : 15،7٪.
ج. العنف اللفظي بنسبة : 8، 21٪، ومجموع ثلاثتها: 35،5%.
د. أنواع أخرى من العنف بنسبة : 8 %.
3. أن مصادر العنف كانت
أ. من الزوج بنسبة: 49،4٪.
ب. من الأب بنسبة : 16،15 %.
ج. من الإخوة بنسبة : 8، 15%.
د. من الأم بنسبة 4، 4 %.
ه. من الأقارب بنسبة : 8،9 %.
و. من الأولاد بنسبة : 2،15 %.
ز. مصادر أخرى للعنف بنسبة : 2،8 %.
4. أن أشكال العنف هي:
ح. العنف الأسري بنسبة : 67،3%.
ط. العنف الاجتماعي بنسبة : 6، 9 %.
ي. العنف الديني بنسبة : 8 5.
ص: 539
ك. العنف الاقتصادي بنسبة : 5،3٪.
ل. العنف نتيجة الأعراف والتقاليد: 2،8%.
م. العنف الثقافي بنسبة : 2،5 %.
ن. العنف نتيجة ممارسات أخرى مختلفة بنسبة : 2،2 %.
س. العنف السياسي بنسبة : 1،1 %.
ع. العنف نتيجة ممارسات قانونية خاطئة بنسبة : 7، 0 %.
ف. العنف نتيجة ممارسات خاطئة للحكومة بنسبة : 0،5 ٪.
5. أن أمكن للرجل ممارسة العنف في :
أ. البيت بنسبة : 95، 80 %
ب. الشارع بنسبة : 12،65 %
ج. العمل بنسبة : 1،9 %
د. المدرسة بنسبة : 1،85 %
ه. المعهد أو الكلية بنسبة : 75، 0 %
و. في أماكن أخرى مختلفة بنسبة : 1،6%.
6. أن أسباب العنف هي:
ز. كسب المال بنسبة : 36 %
ح. الغضب بنسبة : 37،35 %
ص: 540
ط. ردة فعل لأمر ما بنسبة 7،75 %
ي. إبراز عضلات بنسبة : 55، 10%
ك. مطامع جنسية بنسبة : 3،35 %
ل. عدم تطبيق الأعراف والتقاليد بنسبة : 85، 2 %
م. أسباب أخرى بنسبة : 1،85%.
7. بماذا تفكر المرأة عند حدوث العنف:
أ. بالانتحار بنسبة : 19،7 %
ب. بتأنيب النفس بنسبة : 18،2 %
ج. بالانتقام من الآخرين بنسبة : 11،75 %
د. بالسكوت وكظم الغيض بنسبة : 42،9 %
ه. بالسكوت لأن المرأة مقتنعة بالعنف الذي وقع عليها بنسبة : 5،55٪
و. بلا شيء بنسبة : 0،15 ٪
ز. بأمور أخرى بنسبة : 1،55٪.
8. بماذا تتصرف المرأة عند حدوث العنف
أ. باللجوء إلى القضاء 13،4 %
ب. باللجوء إلى الأهل 28،45 %.
ج. باللجوء إلى ذوي العقل والحكمة 18،05 %.
ص: 541
د. بالسكوت خوفا من العواقب 27،45 %.
ه. باللجوء إلى أمور أخرى أو آخرين: 7،75 %.
9. نتائج العنف
أ. تعاسة دائمة بنسبة : 45،05٪.
ب. حب الانتقام بنسبة : 11،85 %.
ج. عدم المحبة بنسبة : 94 %.
د. الغيرة والكره بنسبة : 7،3 %.
ه. اضطراب وقلق بنسبة : 13 %.
و. الخوف 8،1 %.
ز. لا يوجد بنسبة : 1،25 %.
ح. نتائج أخرى بنسبة : 7،1٪.
(ينظر الملحق التاسع والعشرون)
ص: 542
وفيه مطلبان :
في اواخر سنة (1426 ه / 2005) طلبت قناة الفرات الفضائية من سماحة السيد رشيد الحسيني ان يقدم برنامجا دينيا فقهيا يطرح فيه مناسك الحج لحجاج بيت اللّه الحرم تحت عنوان (فقه المصطفى).
وبعد استشارة بعض المراجع العظام والأساتذة في حوزة النجف الأشرف عن مدى أهمية برنامج تبليغي يتناول طرح القضايا الفقهية والأخلاقية بطريقة مبسطة وواضحة يصاحبها فتح باب الأسئلة المباشرة من المواطنين للاستفسار عن مسائلهم ومشاكلهم والإجابة عنها في الحال بدأ سماحته بتسجيل حلقات (مناسك الحج) في خمس وعشرين حلقة تلفزيونية خاصة بثت عبر (قناة الفرات الفضائية) في أيام شهر ذي القعدة الحرام حيث لاقت قبولا حسنا من قبل المؤمنين وخاصة حجاج بيت اللّه الحرام.
وهو ما استدعى القائمين على إدارة (قناة الفرات الفضائية) أن يقترحوا بان يكون هناك برنامج فقهي يومي يتناول الإجابة عن المسائل الشرعية المختلفة التي يبتلي بها المؤمنون في حياتهم اليومية بشكل عام ويودون تحصيل الإجابة عنها بوضوح ومباشرة.
عندها بدأ سماحة السيد رشيد الحسيني باعداد وتقديم هذا البرنامج من بداية
ص: 543
مسائل التقليد وما بعدها من المسائل الشرعية عبادات ومعاملات، وقد بثت هذه الحلقات بشكل يومي على مدى ثلاث حلقات في اليوم فلاقت قبولا ملفتا على صعيد العراق وخارجه، وقد خصصت (قناة الفرات الفضائية) مشكورة صفحة على موقعها الالكتروني لاستقبال آراء المشاهدين، وكان للبرنامج المرتبة الاولى في عدد الزيارات والمشاركات وأكثرها قراءة كما اشار المشرفون على الموقع.
ونتيجة لوضوح الحاجة الماسة إلى أمثال هذه البرامج المباشرة فتح سماحة السيد رشيد الحسيني خطا تلفونيا لاستقبال الأسئلة والإجابة عنها ففوجئ بالكم الهائل من الاتصالات اليومية التي تخطت حدود 400 اتصال تلفوني في ساعات قصيرة ما استدعى تكثير الخطوط التلفونية إلى خمسة خطوط مستعينا بعدد من فضلاء الحوزة العلمية في النجف الأشرف ليقوموا بمساعدته في الرد على الاتصالات والإجابة عن الاستفتاءات الشرعية فكانت البذرة الأولى لتشكيل (مؤسسة المصطفى للارشاد والتوعية الدينية
تتكون المؤسسة من أقسام عدة هي:
أولا - قسم الاجوبة على المسائل الشرعية: وتعنى بالرد على الاتصالات التلفونية حصرا، وقد وصل عدد الاتصالات التلفونية في شهر رمضان إلى 700 اتصال يوميا.
ثانيا – قسم الاجابة عن الرسائل القصيرة التي ترد إلى المؤسسة: ويستقبل هذا القسم حاليا مئات الرسائل القصيرة يوميا ويقوم بعض أفاضل طلاب الحوزة العلمية بالاجابة عنها سريعا.
ثالثا - قسم الانترنت: ويعنى بالرد على الاستفتاءات الواردة عبر الانترنت حيث
ص: 544
تجيب المؤسسة مباشرة على صفحة (الفيس بوك ) الخاصة بالمؤسسة.
رابعا - قسم التأليف والنشر: ويعنى بكتابة المسائل الشرعية بلغة مبسطة وسهلة ليتسنى للمؤمنين، وخاصة شريحة الشباب منهم، وقد اصدرت المؤسسة عدة كراسات مبسطة تناولت تبيان الأحكام الشرعية في الصيام والشعائر الحسينية والتقليد والصلاة والحج والنفاس تحت العناوين التالية وهي:
(موجز أحكام الصيام)
( الشعائر الحسينية في 100 سؤال )
(موجز أحكام التقليد والصلاة)
(بروشور خاص بمناسك حج التمتع )
(بروشور خاص بمناسك العمرة المفردة)
(لوحات خاصة بأحكام النفاس)
خامسا - قسم التبليغ والارشاد ويعنى بالتنسيق بين المبلغين الكرام والمناطق المحتاجة من أجل تشخيص الحاجة وسدها قدر الإمكان، كما يهتم بإقامة دورات تعليمية وتثقيفية أسبوعية في بعض المناطق القريبة من مدينة النجف الاشرف.
سادسا - قسم الخدمات والامور الخيرية : ويعنى بمساعدة الفقراء وقضاء حوائج الايتام وغيرها من الخدمات الأخرى الممكنة
ص: 545
ص: 546
ويتضمن هذا الفصل مقدمة وثلاثة مباحث هي:
المبحث الأول : هوية المؤسسة وأهدافها وآليات تحقيق تلك الأهداف.
المبحث الثاني: خطوطها العامة
المبحث الثالث: نشاطاتها
وسأتناولها تباعا فيما يأتي:
ص: 547
ص: 548
نظرا لأن النجف الأشرف لا تزال وستبقى تحتاج إلى المزيد من العطاء والجهود وخاصة في المجال التبليغي لتتمكن من النهوض بالمهمة الملقاة على عاتقها إلى المستوى الذي يتناسب مع رسالتها، منهجاً وإنتاجاً، وتطوراً مع سر مع سرعة المتغيرات العالمية والعلمية، ناهيك عن الحاجة إلى تهذيب النفوس وتزكيتها، وترسيخ الأخلاق التي بعث الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لإتمامها، بات لزاما على المهتمين بهذا الجانب المهم أن يشمروا عن ساعد الجد عسى أن يوفقوا لتحقيق ما يطمحون اليه من غايات وبلوغ ما يرجون من مهمات.
من هنا انبثقت فكرة إنشاء مؤسسة الشيخ زين الدين ل للمعارف الإسلامية.
ومن أجل أن ألقي الضوء على واقع هذه المؤسسة ونشاطاتها فقد قسمتها إلى مباحث ثلاثة هي:
ص: 549
ص: 550
أ - مؤسسة الشيخ زين الدين (قدّس سِرُّه) للمعارف الإسلامية، مؤسسة ثقافية إسلامية، ذات شخصية مستقلة، تستظل بخط المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وتعتمد الرؤية العلمية الحوزوية الأصيلة، وهي تطمح إلى التوفيق بين هذه الأصالة، والضرورات المتجددة للمرحلة الراهنة، والآفاق المستقبلية، مشددة على العمق العلمي الحوزوي، واقترانه بثبات الإيمان، والتزام التقوى، وحيث يعنيه قوله (تعالى): «يَرْفَعِ اللّه الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٍ». (المجادلة: 11)
ب- لا تنتمي المؤسسة إلى أي من الحركات السياسية، وتحترم المرجعيات الدينية الحقة، كما تحترم كل عمل علمي أو ثقافي رائد، وهي تسعى لمد جسور التعاون مع المؤسسات المماثلة في الثوابت والأهداف والوسائل، من جامعات وجمعيات دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية.
للمؤسسة أهداف عامة محددة هي :
أ- تنمية ارتباط الطالب الحوزوي بالثوابت المبدئية التي أنشئت عليها الحوزة العلمية، من عمق الإيمان والمعرفة بالله (تعالى)، والإخلاص له في النيات والأعمال،
ص: 551
والتوكل عليه في جميع الأمور، والتحلي بمكارم أخلاق أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).
ب- الحفاظ على أصالة وعمق الجانب العلمي لدى طلبة العلوم في الحوزة العلمية في النجف الأشرف وفروعها، مع مراعاة المتطلبات الملحة والمتسارعة لحاجات المجتمع الفكرية والعقائدية والعلمية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية، مما يجعل الطالب الحوزوي عنصراً عاملاً وفاعلاً فيما يجري حوله من متغيرات علمية وحضارية، وفق المنهج الإسلامي الرشيد.
ت- إعداد الطالب الحوزوي لأن يكون مثقفاً - مطلعاً اطلاعاً مناسباً على مجمل أبعاد الثقافة العامة التي تمكنه من القيام بمهماته الكبرى في المجتمع، وتبليغ كلمة اللّه فيه.
ث- فتح باب التواصل بين الحوزة والمؤسسات العلمية والثقافية الأخرى، للاستفادة من خبرة هذه المؤسسات في رفع كفاءة طلبة الحوزة العلمية، وتهيئتهم لأداء مهماتهم المختلفة، ولتقديم كل ما تحتاجه كوادر تلك المؤسسات من الرؤى الإسلامية الأصيلة التي تعنى بها الحوزة.
ج- تشجيع الأبحاث المتخصصة في المجالات العلمية والتبليغية، والمعارف الإسلامية في آفاقها المختلفة، وتهيئة السبل لنشر ما ترى أهليته للنشر منها.
ح- السعي لإصدار وطباعة الكتب والنشرات النافعة للمجتمع المؤمن في مختلف
حقول المعارف الإسلامية، أو ما تكون من مقدماتها أو مؤيدات.
أما آليات تحقيق مؤسسة الشيخ زين الدين لأهدافها فهي:
ص: 552
أ- تشخيص ما يحتاجه المجتمع المسلم لتحقيق انتمائه الإسلامي السليم، ووضع الخطط المناسبة للوفاء بتلك الحاجات وبالطرق الممكنة والوسائل المتبعة.
ب- إعداد الطالب الحوزوي للقيام بدوره فيه دراسة وكتابة وتبليغاً، وتهيئة ما يحتاجه في هذا السبيل، ولا سيما الوسائل المعاصرة منها.
ت- التنسيق مع أساتذة أكفاء معروفين بإخلاصهم وإيمانهم وعلمهم، من الحوزة العلمية الشريفة، أو من الجامعات العراقية، بل وغير العراقية -مع تهيؤ الفرص المناسبة-، فضلاً عن ذوي الخبرة، ممن يستطيعون القيام بتحقيق الممكن من الأهداف المذكورة، مضافاً إلى الاستعانة ببعض المؤسسات والمتبرعين - كفاءةً أو أموالاً - للعمل بما يصب في تحقيق تلك الأهداف.
ث- رصد كل ما من شأنه أن يتعارض مع الهدف الأول، والعمل على رفضه واستنكاره بما هو ممكن ضمن الأوساط الحوزوية.
ج- وضع نظام داخلي للمؤسسة، وتشكيل هيئة رئاسة (مجلس أمناء)، ولجان متخصصة لإدارة المؤسسة، وخدمة أهدافها، يعينها ويحدد مسؤولياتها مجلس الأمناء.
ص: 553
ص: 554
المؤسسة الشيخ زين الدين نظام ذو مواد محددة هي :
المادة :(1) تنشأ المؤسسة باسم (مؤسسة الشيخ زين الدين قده سره للمعارف الإسلامية).
المادة (2): تكون لهذه المؤسسة شخصية معنوية، مستقلة مالياً وإدارياً، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة التي تخولها القيام بجميع التصرفات الشرعية تحقيقاً لأهدافها المذكورة في المقدمة.
المادة (3): مقر المؤسسة مدينة النجف الأشرف، ولها أن تفتح فروعاً في داخل العراق، أو في خارجه، حين تتطلب الأمور، وتساعد الظروف على ذلك.
المادة (4): تخضع المؤسسة لثوابت الشريعة الإسلامية المقدسة، الواصلة إلينا من خلال الأئمة الاثني عشر من آل البيت (صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين).
وتلتزم أيضا بجميع التقاليد الحوزوية في شعاراتها وشعائرها السامية.
المادة (5) : تلتزم المؤسسة بجميع المتطلبات التي تمكنها من أداء مهامها، ما دامت لا تتنافى مع التزاماتها الأخرى، كما أنها لا تخالف القوانين المعمول بها في البلاد التي تعمل فيها.
المادة (6) : الموارد المالية للمؤسسة مصدرها ما يأتي:
ص: 555
1 - مساهمة الجهة المؤسسة.
2 - مساعدة المراجع (أعلى اللّه مقامهم).
3- التبرعات من الراغبين في دعم المؤسسة، من داخل العراق أو خارجه.
4 - الأوقاف والوصايا، والموارد الخيرية العامة... الخ.
5- الإيرادات الخاصة بالمؤسسة من أرباح مبيعاتها من مطبوعات أو تسجيلات أو غيرها.
المادة (7) : إذا ألغيت المؤسسة - لا سمح اللّه - ولأي سبب كان، تعود جميع ممتلكاتها الخاصة بها، المنقولة وغير المنقولة إلى مؤسسة مماثلة -إن وجدت-، وإلا فالأقرب من المؤسسات في الأهداف، ويشخص ذلك المرجع الأعلى، أو من يخوله بالتشخيص من أهل الخبرة.
المادة (8) الجهة المؤسسة المتمثلة ب ( ضياء الدين زين الدين) هي الجهة المخولة في اختيار هيئة عليا باسم (مجلس الأمناء).
المادة (9): يتشكل مجلس الأمناء ممن عرف بالتقوى والإخلاص من فضلاء الحوزة العلمية، لا يقل عددهم عن اثنين، إضافة إلى الجهة المؤسسة، ينتخبون من بينهم رئيساً، ومهمة هذا المجلس :
أولاً : بناء الهيكل الإداري للمؤسسة، وتعيين اللجان المتخصصة فيها، وحسب الحاجة التي يقتضيها سير العمل لتحقيق أهدافها المذكورة في المقدمة.
ثانياً : الإشراف المباشر على مجريات العمل في المؤسسة، من خلال ما يقدمه رئيس مجلس الإدارة من تقارير دورية أو إشعارات خاصة يستوجبها سير العمل، واتخاذ نظام المؤسسة
ص: 556
القرارات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.
المادة (10) : يبدأ العمل في المؤسسة من خلال:
ووظيفته : الإشراف الكامل على سير أعمال المؤسسة من خلال مقررات مجلس الأمناء، وتبليغها إلى الأقسام ومتابعة تنفيذها، وتنظيم علاقاتها مع المؤسسات والهيئات المشابهة، ومختلف الجهات والشخصيات التي تحتاج المؤسسة إلى الاتصال بها، وضبط مواردها ومصروفاتها.
ويتكون مجلس الإدارة من :
أ - رئيس مجلس الإدارة، ووظيفته: الإشراف على تنفيذ جميع المهمات المنوطة بمجلس الإدارة، ومتابعة شؤون الموظفين وسير أعماهم، والبت بجميع القرارات التي يتخذها المجلس، ورفع تقارير عن سير الأعمال إلى مجلس الأمناء في جلساته الدورية والاستثنائية، ويشترط فيه : أن يكون محل تقدير في الأوساط الحوزوية، ولا يقل مستواه العلمي عن التأهل لحضور البحث الخارج في الدراسة الحوزوية. وأن يتمتع بخبرة إدارية جيدة، وشخصية قوية تمكنه من القيام بعمله بكفاءة وحزم.
ب- رؤساء الأقسام، حيث يكون رئيس كل قسم في المؤسسة عضواً في مجلس الإدارة.
ج- الموظفون التابعون لمجلس الإدارة وهم : موظف الذاتية، ووظيفته توثيق كل ما يتصل بشؤون منتسبي وأعضاء المؤسسة، وفتح سجلات خاصة لمجلسي الأمناء والإدارة ولكل قسم من أقسام المؤسسة توثق فيها مجمل أعمالها ونشاطاتها، وحفظ محاضر جلساتها ومقرراتها. ويشترط فيه أن لا تقل الشهادة التي يحملها عن درجة
ص: 557
البكلوريوس، ويفضل أن يكون خريج كلية الإدارة والاقتصاد.
ومسؤول العلاقات العامة، ومهمته تنسيق الاتصالات مع الأفراد والهيئات والمؤسسات التي تقرر المؤسسة الاتصال بها، وضبط طرق ومواعيد الاتصال، وتوثيقها. وكاتب يستقبل أسماء الطلبة الذين يتقدمون لحضور الدروس التي تقررها اللجان المختصة، وتوثيق الشروط المطلوبة في كل طالب ومتابعة حضور وغيابات الطلبة في كل دورة وتقديمها لمجلس الإدارة أو للجنة المختصة للبت فيها واتخاذ اللازم. ومحاسب، ومهمته المتابعة المالية للمؤسسة، وتوثيق وارداتها ومصروفاتها، ووضعها في سجلات خاصة، لتقدم إلى مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة عند الطلب. وأمين مكتبة، ومهمته الإشراف على مكتبة المؤسسة وإصداراتها، وتنظيم سجلاتها، ومتابعة إعاراتها و هداياها، وتوثيق الصادر والوارد من الكتب - التي تتولى المؤسسة نشرها- وأعدادها، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون المكتبة. إضافة إلى عاملين آخرين تحدد أعدادهم ووظائفهم حاجة العمل، وبحسب ما يقترحه مجلس الإدارة، ويقره مجلس الأمناء.
للمؤسسة أقسام متخصصة هي:
1 - القسم العلمي: ومهمته الإشراف على مجمل الأعمال والنشاطات العلمية والفكرية التي تقوم بها المؤسسة، بما فيها الإجابة عما يرد عليها من الأسئلة، وتقويم الكتب التي تقرر لدورات الدراسة أو للتحقيق والنشر، وكذلك الأساتذة الذين ينتدبون للتدريس في دورات المؤسسة، وإحالة ما هو خارج عن اختصاص أعضائه على ذوي الاختصاص في داخل الحوزة العلمية أو في خارجها، وذلك بالتنسيق مع مجلسي الأمناء والإدارة، والأقسام الأخرى ذات العلاقة بتلك الموضوعات.
ويتكوّن هذا القسم من عدة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً، مهمته:
ص: 558
أ - تمثيل القسم في مجلس الإدارة، وحسب ما هو مذكور في عضوية رؤساء الأقسام في المجلس.
ب - تنسيق أعمال القسم وفق ما يقرره النظام الداخلي للمؤسسة.
ويشترط في أعضاء القسم أن يكونوا جميعاً من طلبة الحوزة العلمية المؤهلين لحضور البحث الخارج على الأقل، وحاملين لشهادات جامعية لا تقل عن البكلوريوس.
2 - القسم الحوزوي ومهمته فتح مجالات الاتصال مع فضلاء الحوزة العلمية وطلبتها، وتقويم الحاجات العلمية والمنهجية الموجودة في المنهج الحوزوي، وتهيئة ما يمكن أن تكفى به هذه الحاجات، والتصدي لفتح دروس خاصة لسدادها، ضمن شرائط ومستويات محددة، واختيار الأساتذة الأكفاء من داخل الحوزة العلمية أو من خارجها، وبالتنسيق مع مجلسي الأمناء والإدارة في جميع الخطوات.
ويتكون القسم من ثلاثة أعضاء -على الأقل - يختارون من بينهم رئيساً، مهمته:
أ – تمثيل القسم في مجلس الإدارة، وحسب ما هو مذكور في عضوية رؤساء الأقسام في المجلس.
ب - تنسيق أعمال القسم وفق ما يقرره النظام الداخلي للمؤسسة.
ويشترط في أعضاء القسم جميعاً أن يكونوا من طلبة الحوزة العلمية المؤهلين لحضور البحث الخارج على الأقل.
3- القسم التبليغي والخطابي : ومهمته إعداد كوادر من الحوزة العلمية وخطباء المنبر الحسيني لأداء مهماتهم التبليغية والخطابية وتدريبهم على القيام بما يلزمهم في هذا المجال، وبالمستوى الذي يتناسب وحاجة العصر الحاضر، وذلك بما يلي:
ص: 559
أولاً : إعداد المناهج التدريسية المناسبة (بعد الاطلاع على مناهج المعاهد المماثلة)، على أن تضاف هذه المناهج إلى المناهج الحوزوية المتبعة، لأنها ليست بديلاً عنها.
ثانياً: فتح دورات لتدريس تلك المناهج، واختيار الأساتذة الأكفاء من داخل الحوزة العلمية أو من خارجها، وحسب الحاجة، على أن تحدد المستويات والشروط المطلوبة في الطلبة والأساتذة الذين يراد انتسابهم لتلك الدورات بشكل واضح، وبالتنسيق مع مجلسي الأمناء والإدارة.
ويتكون هذا القسم من فرعين
أحدهما فرع التبليغ الديني، ومهمته تهيئة طلبة الحوزة العلمية لأداء واجباتهم التبليغية في مختلف المجالات التي تفرضها حاجة العصر.
ثانيهما: فرع الخطابة الحسينية، ومهمته تهيئة خطباء المنبر الحسيني للقيام بوظيفتهم في خدمة هذا المنبر وفق الحاجة المعاصرة للمجتمع.
ويتكون كادر هذا القسم من :
1. رئيس القسم، ومهمته:
أ - تمثيل القسم في مجلس الإدارة، وحسب ما هو مذكور في عضوية رؤساء الأقسام في المجلس.
ب - تنسيق أعمال القسم بكلا،فرعيه، وتقسيم مهام العمل بين الفرعين وفق ما يقرره النظام الداخلي للمؤسسة.
ويشترط في رئيس القسم أن يكون من طلبة الحوزة العلمية المؤهلين لحضور البحث الخارج، وأن تكون له خبرة خطابية وتبليغية مناسبة تؤهله للقيام بالمهمة الموكولة إليه.
ص: 560
2- المعاون العلمي لفرع التبليغ الديني، ومهمته تنفيذ مقررات القسم فيما يحتاجه فرعه من دراسة حاجات المبلغين الدينيين من العلوم والمعارف والخبرات المطلوبة في أداء مهماتهم المختلفة، واختيار أو وضع المناهج المناسبة للوفاء بتلك الحاجات، واقتراح المصادر أو الأساتذة المؤهلين للقيام بهذه المهمة، ووفق الخطة التي يقرها رئيس القسم.
ويشترط فيه أن يكون من المؤهلين لحضور البحث الخارج في الدراسات الحوزوية، و ممن له خبرة كافية في التبليغ الديني ومستلزماته.
3- المعاون العلمي لفرع الخطابة، ومهمته تنفيذ مقررات القسم فيما يحتاجه فرعه، من دراسة حاجات خطباء المنبر الحسيني من العلوم والمعارف والخبرات المطلوبة، واختيار أو وضع المناهج المناسبة لسداد تلك الحاجات واقتراح المصادر والأساتذة المؤهلين للقيام بهذه المهمة ووفق خطة العمل التي يقرها رئيس القسم.
ويشترط فيه أن يكون من خطباء المنبر الحسيني، ومن المؤهلين لحضور البحث الخارج في الدراسات الحوزوية.
4 - قسم التحقيق والتأليف والنشر، ومهمته :
أولاً: التماس محققين – ممن ثبتت كفاءتهم في التحقيق من داخل الحوزة العلمية أو من خارجها - لكتب التراث المحالة إليها من مجلسي الأمناء والإدارة.
ثانياً : التماس مؤلفين - ممن ثبتت كفاءتهم في التأليف من داخل الحوزة العلمية أو من خارجها - للكتابة في المواضيع التي يقترح مجلسا الأمناء والإدارة الكتابة فيها.
ثالثاً - : القيام بطباعة ونشر الكتب والبحوث التي تحال للقسم من مجلسي الأمناء والإدارة، وحسب ما تقتضيه الحاجة.
ص: 561
ويتكون كادر هذا القسم من ثلاثة من طلبة الحوزة العلمية المؤهلين للقيام بهذه المهمات، يختارون من بينهم رئيساً له مهامه المنصوص عليها في النظام.
5 - قسم الحاسوب والانترنيت، ومهمته:
أولاً : إنشاء موقع خاص للمؤسسة يتناسب وطبيعة عملها الإسلامي وعلاقاتها العامة.
ثانياً : مواصلة الإشراف على موقع المؤسسة، والتواصل مع من يريد التواصل معها في هذا المجال، واستقبال المقترحات والأسئلة والبحوث التي تقدم لها، وإحالة ما تجب إحالته على اللجان المختصة لاتخاذ اللازم، مع الإجابة على ما ينبغي الإجابة عليه من الأسئلة والمقترحات.
ثالثاً تنضيد ما تحتاجه المؤسسة من الرسائل والكتب والبحوث، وتوثيقها وتسهيل مراجعتها
رابعاً: التخاطب مع المواقع والمؤسسات الأخرى المشابهة، لإغناء الموقع وتسهيل سبل البحث والمراجعة لأعضاء اللجان في دراساتهم المطلوبة، ونشر فاعليات المؤسسة ضمن الأطر المناسبة.
خامساً: الاستعانة بفنيين بعمل الحاسوب والموقع، وحسب ما يراه مجلس الإدارة لازماً لتمضية أعمال المؤسسة، وتحدد الأجور ضمن الضوابط المتبعة في هذه المجالات. ويتشكل القسم من :
1 - رئيس يشترط أن يكون من طلبة الحوزة العلمية المؤهلين لدراسة السطوح- على الأقل - وله من القدرة النحوية، والاطلاع العلمي والثقافي ما يمكّنه من تنقية الكتب والبحوث التي يراد جعلها على الموقع أو المنتدى من الأخطاء النحوية والعلمية
ص: 562
والإملائية، ومهمته :
2- فنيين بعمل الحاسوب والموقع، ويقرر عددهم بحسب ما يراه مجلس الإدارة لازماً لتمضية أعمال المؤسسة.
1 - يتعين توزيع الأعمال التي تحقق أهداف المؤسسة نوعاً وكماً على الأقسام، على أساس من الكفاءة العلمية والفنية والإدارية والإيمانية بما يحقق الهدف بجدارة، حيث يشترط في جميع المنتسبين للمؤسسة أن يكونوا من ذوي الإيمان والورع، والأخلاق الفاضلة، ومن الملتزمين بخط المرجعية العليا، ونهج الحوزة العلمية الأصيل.
2 - لا يجوز ان تتعامل المؤسسة بقاعدة (لا يسقط الميسور بالمعسور)، حينما لا تتكامل لديها الكادر والخبرة اللازمة في فرع من فروعها، أو مشروع من مشاريعها، أو خط من خطوط أهدافها، حيث يمكنها تأجيل العمل في ذلك الفرع أو المشروع ريثما تتكامل الخبرة الكافية فيه، والتركيز على الفرع المتكامل الخبرة والكادر المطلوب.
كما لا يفرق -في اتباع هذا المبدأ - بين أن يكون للعامل صلة قرابة -وإن كان ولداً، أو أنه ممن يحتاج إلى العمل لتحصيل قوته، وما إلى ذلك من الأمور الجانبية التي تنعكس على المشروع في أدائه.
ص: 563
ص: 564
للمؤسسة نشاطات عدة منها :
لقد كان الهدف من انشاء هذه الحلقة هو إعداد طلبة متخصصين في المسائل العقائدية وكتابة البحوث المتخصصة وحل الإشكالات العقائدية المطروحة في الساحة كما يمكن الإستعانة بهم في الإجابة على الأسئلة والإشكالات المطروحة على شبكة المعلومات العالمية (الانترنيت) وكل ما يتعلق بالقضايا العقائدية الأخرى.
أما مستوى الطلبة الذين أنتموا إلى الحلقة العقائدية فكانوا من طلبة السطح العالي (كفاية، مكاسب) وممن درسوا الكتب المنطقية المتعارفة في الحوزة وبشكل جيد وهي منطق المظفر، وحاشية الملا عبد اللّه وبعض شروحها، والرسالة الشمسية وبعض شروحها، وكذلك ممن درّسوا بعض الكتب العقائدية كالباب الحادي عشر وبعض شروحه، وشرح تجريد الإعتقاد مع بعض الشروح.
لقد كان عدد الطلبة الذين أنتموا إلى هذه الحلقة (9) طالباً، إختارت المؤسسة أحد أساتذة الحوزة العلمية للإشراف على هذه المجموعة وإعداد برنامج مناسب لهم، ولتحقيق الأهداف المرسومة للحلقة ووفرت المؤسسة كل ما يحتاج اليه الطلبة من مستلزمات البحث والدراسة.
ص: 565
من اجل القيام بالمسؤولية التبليغية الملقاة على عاتق الطالب الحوزوي الذي نذر نفسه في سبيل تحملها وأدائها بأحسن مستوياتها ومراتبها ومن أجل إطلاع المبلغين على القضايا الفكرية المعاصرة
أقامت مؤسسة الشيخ زين الدين (قدّس سِرُّه) للمعارف الإسلامية دورة الفكر المعاصر للفترة من (6) جمادى الأخرة ولغاية (15) جمادى الآخرة من العام 1430 ه / 2009م، وقد بلغ عدد الحضور من الطلبة المبلغين (90) مبلغاً.
مواد الدورة:
لكل مادة يوم واحد يلقى فيه محاضرتان مدة المحاضرة (45) دقيقة يتخللها إستراحة (15) دقيقة.
قراءة عامة في الحداثة.
قراءة في فكر عبد الكريم سروش.
قراءة في فكر محمد أركون.
قراءة في فكر محمد عابد الجابري.
الثابت والمتحول.
خبرات تبليغية.
أساتذة الدورة:
تم الإتفاق مع مجموعة من أساتذة الحوزة العلمية الشريفة لإلقاء هذه المحاضرات وهي كما يلي:
ص: 566
سماحة السيد احمد الأشكوري ألقى محاضرتين :
قراءة عامة في الحداثة.
قراءة في فكر عبد الكريم سروش.
سماحة السيد محمد علي بحر العلوم القى محاضرة بعنوان (قراءة في فكر محمد عابد الجابري).
سماحة السيد جعفر الحكيم ألقى محاضرة بعنوان (الثابت والمتحول).
سماحة الشيخ ستار الجيزاني ألقى محاضرة بعنوان (قراءة في فكر محمد أركون).
سماحة السيد علاء الموسوي ألقى محاضرة بعنوان (خبرات تبليغية).
أقامت مؤسسة الشيخ زين الدين (قدّس سِرُّه) للمعارف الإسلامية دورتها التكميلية الأولى للفترة من (9) شوال) ولغاية (25) ذي الحجة ) من العام 1428 ه/ 2007م واضعة لهذه الدورة المواد التالية وهي:
علم الإجتماع علم النفس. مناهج البحث العلمي. الثقافة القانونية. الفكر المعاصر.
أما دوام الدورة فكان بواقع خمسة أيام في الأسبوع لكل مادة يوم واحد في الإسبوع يلقى فيها محاضرتان، مدة المحاضرة (45) دقيقة يتخللها إستراحة (15) دقيقة.
لقد انتظم في هذه الدورة أربعون طالباً بمستوى طلبة السطوح وبحث الخارج.
أما أساتذتها فقد تم الإتفاق مع أساتذة أكاديمين متخصصين لهم خبرة في التدريس في الجامعات العراقية حيث تولى تدريس مادة علم النفس كل من الأستاذين:
ص: 567
د. خليل الأعسم، ود. حسين الحسيني، وتولى تدريس مادة مناهج البحث العلمي : د. صادق المخزومي، في حين تولى تدريس مادة الثقافة القانونية أ.م.د علي الشكري وزير التخطيط الحالي، وتولى تدريس مادة الفكر المعاصر السيد هشام السياب.
أقامت مؤسسة الشيخ زين الدين (قدّس سِرُّه) للمعارف الإسلامية دورتها التكميلية الثانية للفترة من الأول من ربيع الأول ولغاية نهاية جمادي الآخرة للعام 1430 ه- / 2009م.
وقد حددت المؤسسة مواد الدورة التكميلية هذه بالآتي:
علم الإجتماع علم النفس الفلسفة الحديثة، علوم القرآن.
وقد انتظم في هذه الدورة (177) طالباً وهو ما فاق قدرة إستيعاب بناية المؤسسة بالنسبة إلى القاعة الدراسية المخصصة لهم فتم قبول (113) طالباً وكان مستويات الطلبة سطوح وبحث الخارج.
أما دوام الدورة فكان بواقع أربعة أيام في الإسبوع لكل مادة يوم واحد تلقى فيها محاضرتان بزمن قدره (45) دقيقة لكل محاضرة تتخللها إستراحة لمدة (15) دقيقة.
أما أساتذة هذه الدورة فهم كل من : سماحة الشيخ ضياء الدين زين الدين لمادة علوم القرآن والأساتذة أحمد جعفر صادق لعلم الاجتماع، وعلي اليوسفي لعلم النفس، و د. جواد كاظم سماري للفلسفة الحديثة.
الكل يعلم ان التبليغ هو وظيفة الأنبياء وأوصيائهم ومن بعدهم وظيفة العلماء العاملين الربانيين وحمل هذه المسؤولية الإسلامية الكبرى يتطلب خبرات عالية في
ص: 568
جميع النواحي العلمية والدينية والإجتماعية والسلوكية ومن أجل رفد الطلبة المبلغين بهذه الخبرات باشرت المؤسسة وبالتعاون مع مكتب آية اللّه العظمى السيد محمد سعيد الحكيم - بالندوات التبليغية المتصاعدة على أن تكون الندوة ثلاثة أيام من كل شهر يحضر في الندوة ستون مبلغاً يطرح فيها المادة العلمية والخبرات التبليغية والتربوية ويتم بعد ذلك الحوار وطرح الأسئلة المهمة والمشكلات التبليغية التي يواجهها المبلغون ثم بعد ذلك تقرر هذه الندوة وتوزع على المبلغين.
و في الشهر التالي يعطى المبلغ ما قرر في الندوة السابقة وتطرح مواضيع جديدة غير التي طرحت في السابق أو مكملة لها وهكذا في كل ندوة من كل شهر تعطى كل ما قرر في الندوات السابقة وزيادة.
عندما أختار رجل الدين سبيل الأنبياء نهجاً، ومنهاج الصالحين وظيفة ومن أجل أداء هذه المسؤولية الإلهية والمهمة الكبرى تجاه المجتمع في هذه الأيام الدقيقة والحساسة من تاريخ الأمة.
أقامت مؤسسة الشيخ زين الدين (قدّس سِرُّه) للمعارف الإسلامية لقاءات مع نخبة من معتمدي المرجعية للتذاكر في هذه المسؤوليات والمهمات وأدائها بأحسن ما يكون وموافقاً لما جاء في الموازين الشرعية والإسلامية.
و طرح برنامج للقاء يعتمد المحاور التالية:
1. شخصية الوكيل أو المعتمد.
2. ثقة المرجعية العليا في إعتمادها، أو وكالتها له.
ص: 569
3. المجتمع الذي كلف بالأخذ بيده في طريق اللّه تعالى.
4. الغايات الأساسية التي يستهدفها رجل الدين في علاقته مع المجتمع. وقد تمخض من هذه اللقاء كتابة تقاري حول شخصية المعتمد.كما تم أنجاز ثلاثة خطوط من الخطوط العامة لعمل المعتمدين :
الخط الأول : التربية الذاتية.
الخط الثاني: التربية العقائدية.
الخط الثالث: التربية العبادية.
لقد إنشئت الشيخ مؤسسة زين الدين (قدّس سِرُّه) للمعارف الإسلامية سنة 1428 ه- 200م. ويقع مقرها الحالي في جمهورية العراق - النجف الأشرف – شارع السور - مبنى مرقد آية اللّه العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين (قدّس سِرُّه). (ينظر الملحق الثلاثون)
ص: 570
ويتقاسم هذا الفصل مبحثان هما:
المبحث الأول : البداية الأولى للتأسيس.
المبحث الثاني : أقسام المؤسسة
وسأتناولها تباعا مبتدئا بالمبحث الأول منهما.
ص: 571
ص: 572
كانت النواة الأولى للتأسيس (مؤسسة كاشف الغطاء العامة) في (سنة 1413ه - 1993م) وفي ظروف صعبة وقاسية في أيام حكم النظام الصدامي المباد الذي كان عدواً لدوداً للعلم والعلماء.
وكان العمل بادئ ذي بدء مقتصراً على حفظ صور المخطوطات على جهاز الحاسوب وإعداد برنامج عرض خاص بها على الرغم من قلة الخبرات المتوفرة في ذلك الوقت.
استمرت هذه المؤسسة بالعمل في سحب المخطوطات الخاصة بمكتبة كاشف الغطاء وبعد ذلك توسع عملها فشمل سحب مخطوطات المكتبات التي تفضلت مشكورة بالتعاون مع المؤسسة، ومن ثم مخطوطات مكتبات الأسر العلمية النجفية وغيرها.
وكان العمل مقتصراً على مجرد سحب صور لصفحات المخطوطات وإدخالها على جهاز الحاسوب.
وحتى عام 1415ه- 1995م) تطورت برامج الحاسوب إذ صدر برنامج (windows 95) فاغتنمت المؤسسة هذه الفرصة العلمية لإصدار القرص الأول (سنة 1415ه - 1995م) وهو يضم (49) مخطوطة ببرنامج عرض خاص بالمؤسسة.
ص: 573
ثم باشرت بإعداد برامج دينية تعمل على الحاسوب، فأصدرت قرصاً خاصاً بالإمام أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وآخر للإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقرصاً ثالثاً للإمام السجاد (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقرص الأبرار الذي يحتوي على حياة كل من النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) والأئمة الأطهار (عَلَيهِم السَّلَامُ).
ثم في (عام 1417ه- 1997م) بدأت المؤسسة بطباعة ما تيسر من المخطوطات العائدة لعلماء أسرة آل كاشف الغطاء وبعض الكتب المنهجية في حوزة النجف الأشرف العلمية وتوزيعها على طلبة الحوزة العلمية الدينية والباحثين والمحققين مجاناً. وكان هذا العمل هو النواة الأولى لقسم التحقيق وقسم الطباعة والنشر.
واستمر العمل الدائب حتى (عام 1419ه- 1999م) حيث بلغ عدد المخطوطات المصورة أكثر من (1280) مخطوطة مخزونة على (44) قرصاً ليزرياً، وعدد الكتب التي طبعت ووزعت بحدود (40) كتاباً.
أما مجموع الكتب التي نضدت فقط على برنامج (word) فقد بلغ (110) كتاب، وهذه الكتب جميعها تم إدخالها على قرص ليزري وزع مجاناً على كثير من الطلبة والباحثين والمحققين.
صادر النظام الصدامي الأجهزة والحاسبات وآلات التصوير والأقراص الليزرية والعديد من المايكرو فيلم لمئات المخطوطات المحفوظة عليها.
وبعد عام من السبات المفروض قهراً استعادت المؤسسة عافيتها لتجدد العهد والمضي قدماً لتحقيق الغاية المنشودة وبصورة سرية أيضاً، فكانت النتيجة أن بلغ عدد الأقراص الليزرية (62) قرصاً تحمل قرابة (1617) مخطوطة.
واستمرت أيضاً عملية التحقيق لبعض المخطوطات وإدخال الكثير من الكتب على برنامج (word) وطباعة ما تيسر وتوزيعها على طلبة الحوزة العلمية والباحثين
ص: 574
والمحققين أيضاً.
قد كانت المؤسسة تُعْرَف باسم (مؤسسة الذخائر) نظراً لكونه أول أقسامها، إلاّ أنه بعد تعدد الأقسام وتوسع العمل استبدل الإسم إلى (مؤسسة كاشف الغطاء العامة) وأحد أقسامها قسم الذخائر للمخطوطات.
للمؤسسة أقسام ومراكز علمية معنية بالمخطوطات والوثائق وأرشفتها، وهي تقدم خدماتها لطلبة العلوم الحوزوية والأكاديمية والمجتمع بصورة عامة.
وسأتناول في هذا المبحث بشكل موجز أقسام المؤسسة الخاصة بالمخطوطات والوثائق وأرشفتها، تلك التي تم افتتاحها حتى هذا الوقت، وهي كما يأتي:
ذكرت فيما سبق أن هذا القسم من الأقسام الأولى التي أنشئت في بداية إقامة المؤسسة، والهدف الذي يصبو إليه العاملون في هذا القسم هو جمع ما أمكن الحصول عليه من المخطوطات والحفاظ على هذا التراث العلمي ونشره وتوزيعه على أهله مجاناً، الذي هو من حصيلة جهود علمائنا الأعلام في مختلف فنون المعرفة، علماً أن هذه الكنوز بقيت محجوبة في بيوت العلماء وأسرهم ولم يخرج منها إلا النزر القليل، وما زالت تلك المخطوطات مركونة على الرفوف ومخزونة في السراديب تنتظر من يخرجها إلى النور وينشرها على الملأ ويزيل عنها ركام الزمن وغبار الأيام.
وبالطبع كانت هناك جملة أمور ساعدت على عدم نشر ذلك التراث وإبقائه مستوراً البيوت بعيداً عن النشر منها الظرف العام متمثلا بالسلطة المبادة التي سعت سعياً
ص: 575
حثيثاً إلى طمس هذه الكنوز ودفنها ومحو آثارها فذهب الكثير من آثار علمائنا أيدي سبأ.
مضافاً إلى ذلك أنّ بعض القائمين على المكتبات الخاصة امتنعوا من نشر ذلك التراث العلمي وأصروا على بقاء المخطوطات التي تحت حيازتهم في الحرز حرصا عليها وصونا لها، وقسم أصبح يتاجر بها. ولا ننسى أن عملية النشر والطبع تستلزم الكثير من الإمكانيات المادية وغيرها في ذلك الوقت مما ساهم في بقاء تلك المخطوطات مطمورة في الزوايا والرفوف.
يعمل هذا القسم بالآلية التالية:
1 - ترقيم صفحات المخطوطة بشكل فني ودقيق أولا.
2 - عمل بلوغرافيا لكل مخطوطة تحتوي على اسم المخطوطة واسم المؤلف واسم الناسخ ومكان النسخ وتاريخ النسخ والموضوع وعدد الصفحات وطول الصفحة وعرضها وعدد أسطر الصفحة وطول السطر ولون الورق وحالة الورق وحالة النسخ ومعرفة ما إذا كانت المخطوطة كاملة أم ناقصة ثم هذا النقص من الأول أم من الأخير أو كونها ساقطة منها بعض الأوراق.
3- تصوير صفحات المخطوطة كلها ومن ضمنها الغلاف.
4 - تقليب صفحات المخطوطة مقارنة مع الصور التي تم سحبها على جهاز الحاسوب.
5- إرسال صور المخطوطة إلى وحدة المعالجة والتنظيف لإخراجها بأفضل صورة وإزالة الأوساخ من الصورة.
6- إدخال صور المخطوطة في برنامج خاص معد من قبل المؤسسة لعرض
ص: 576
صفحاتها بشكل سهل وبسيط، وقد تم إعداد لكل مكتبة أو شخصية تم سحب مخطوطاتها برنامج خاص بتلك المكتبة يعرض نبذة عن تلك المكتبة أو الشخصية وتاريخها.
7- إرسال المخطوطة إلى قسم التجليد والترميم لمعالجتها من الأمراض المصابة بها من الفطريات والعوالق وغيرها، ثم ترميم وترقيع صفحاتها وتجليدها تجليدا فنيا.
8- عند الانتهاء من سحب صور المخطوطة وترميمها وتجليدها يتم إرجاع المخطوطة إلى أصحابها مع أقراص تحمل صور تلك المخطوطات التي تم تصويرها ببرنامج خاص بتلك المكتبة أو الشخصية وإهداء تلك المكتبة أو الشخصية رفوفاً أو صناديق لحفظ تلك المخطوطات.
9 - كما يقوم هذا القسم أيضا بتحويل المخطوطات المصورة على المايكروفيلم إلى الحاسوب ومن ثم حفظها على الأقراص.
10 - ويقوم بإصدار دليل لمصورات المخطوطات الجديدة بين مدة وأخرى والتي تم تصويرها وفهرستها.
وكان عدد المكتبات العامة ومكتبات الشخصيات العلمية المعروفة التي تعاونت مع عمل المؤسسة في حفظ مخطوطاتها والتي تم الانتهاء قد بلغ حتى الآن (تسعا وثلاثين) مكتبة حيث تم الانتهاء من تصوير ما يربو على (الثلاثين ألف مخطوطة) في مختلف العلوم، ومن المؤمل أن يصل عدد المخطوطات المصوّرة إلى عشرات الآلاف منها.
هذا ويقدم قسم الذخائر للمخطوطات خدماته للباحثين بطريقتين :
الأولى: الطلبات الفردية التي يتقدم بها الباحثون بعد ملء استمارة خاصة لتعيين
ص: 577
المخطوطات التي يحتاجون إليها، فيلبي القسم هذه الطلبات بوضع مصورات تلك المخطوطات على الأقراص الليزرية وتقديمها لهم. ويحصل الباحث على مبتغاه مجاناً في زمن لا يتجاوز ربع ساعة.
الثانية : يقوم القسم بتقديم جميع صور المخطوطات على الأقراص الليزرية وذلك بوضعها في صندوق فاخر مخصص لحفظ الأقراص الليزرية من التلف وإهدائها إلى الحوزات العلمية والجامعات والمراكز العلمية والمكتبات مجانا.
تمثل الوثائق أحد أهم المصادر التاريخية، فالباحث والمؤرخ لا يفتقر إلى شيء في مادته العلمية والبحثية كما يفتقر إلى الوثائق من مراسلات وإجازات رجالية وغير ذلك. فكان في مقدمة اهتمامات مؤسسة كاشف الغطاء العامة افتتاح قسم يهتم بجمع الوثائق وحفظها، ليتسنى للأخوة الباحثين الاستفادة من هذه المادة العلمية، وقد استطاع العاملون في هذا القسم الذي افتتح في (عام 1425ه/ 2005م) الحصول على مجموعة كبيرة من الوثائق من مكتبة كاشف الغطاء العامة كخطوة أولى لما تحتويه هذه المكتبة من الأعلاق النفيسة والوثائق المهمة. كما استطاع القسم أن يجمع عدداً من الوثائق من مكتبات أخرى إما عن طريق الإهداء أو الشراء أو التصوير.
وخلال هذه الفترة الوجيزة أصبح القسم يحتوي على وثائق وطنية أصلية ومصورة ومراسلات تاريخية وملكيات ووقفيات ووصايا ونصائح وخطابات رسمية وفتاوى خطية لعلماء الدين وتراجم للشخصيات ومواقفهم وكذلك المجلات القديمة كما يتابع دورات المجلات الحديثة. وكل ما يمكن الحصول عليه يتم تصويره وإدخاله على الأقراص الليزرية وأما النسخ الأصلية فيتم ترميمها وصيانتها من التلف وإرجاعها إلى
ص: 578
أصحابها.
يستقبل هذا القسم جميع الوثائق ليقوم بتصويرها وأرشفتها أرشفة علمية ومن ثم ترميمها وحفظها على الأقراص الليزرية وإعطاء صاحب الوثيقة نسخة من القرص الليزري. كما يتكفل القسم بتقديم خدماته لطلبة الحوزة العلمية والباحثين والمحققين والمؤرخين، إذ قام القسم بتهيئة برنامج عرض خاص لصور الوثائق يتم من خلاله التحكم بهذه الصور بعرضها وتكبيرها وتصغيرها وتدويرها وإمكانية البحث فيه عن أسماء الوثائق ومواضيعها وتواريخها، كما يعرض البرنامج استمارة خاصة بكل وثيقة تم إدخالها في البرنامج تندرج فيها معلومات عن عنوان الوثيقة وموضوعها والتاريخ الخاص بها وعدد الصفحات وطول الصفحة وعرضها وعدد الأسطر وطول السطر وحالة النسخ وحالة الورق ولون الورق واتجاه النقص إن وجد، مع ذكر أسماء الأشخاص الواردة في الوثيقة، وأسماء المدن، ومصدر الوثيقة.
كما يقوم القسم بإصدار دليل للوثائق المفهرسة التي في حيازة القسم؛ وذلك لإرشاد الباحث إلى الوثيقة المطلوبة بيسر
وقد قام قسم الوثائق بنشر نماذج مختارة من الوثائق ضمن سلسلة بعنوان (الموسوعة الوثائقية).
ويبلغ عدد الوثائق التي حصل عليها القسم حتى اليوم ما يزيد عن (خمس ملايين وثيقة).
لا يخفى على المتتبع أن المخطوطات والكتب القديمة لا يمكن الاستفادة منها عموما إلا بعد تقويم نصوصها وتخريج الآيات القرآنية والأحاديث ونسبة الأقوال
ص: 579
إلى مظانها والتعرف بالأعلام المغمورين دون المشهورين وغيرها من الأمور المكملة العملية التحقيق وكذلك تصحيح ما وَهمَ فيه الناسخ من جهة النحو واللغة وتوضيح ما غمض من معانيها، وكل ذلك لا يتأتى إلا لمن توفرت فيه ملكة التحقيق، فدعت الحاجة إلى افتتاح قسم التحقيق وهو أحد أهم الأقسام التي ترعاها المؤسسة.
يُدار هذا القسم بإشراف لجنة تحقيق تضم بين أعضائها طلبة علوم دينية من الحوزة العلمية في النجف الأشرف وكذلك محققين وباحثين من طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) لاستثمار الطاقات من كلا الجانبين الحوزوي والأكاديمي.
إن إخراج وتحقيق أية مخطوطة إنما يتم بعد الاتفاق على منهج خاص لتحقيق المخطوطة وقد يختلف ذلك المنهج من مخطوطة إلى أخرى فلا بد من وضع خطة مدروسة تتناسب مع ظروف المخطوطة.
وقد تم تحقيق جملة من المخطوطات النادرة بلغت لحد الآن (16) مخطوطة) وكالآتي:
1 - كتاب الإمامة للعلامة الشيخ عباس كاشف الغطاء (1253 ه/ 1323ه) تحقيق مؤسسة كاشف الغطاء العامة. النجف الأشرف. 1425ه/ 2004م.
2 - الأجوبة النجفية عن الفتاوى الوهابية. للعلامة الشيخ هادي كاشف الغطاء (120ه/ 1361ه). النجف الأشرف 1426ه/ 2005م.
3- رسالة في فن التجويد للعلامة الشيخ هادي كاشف الغطاء (1290ه/ 1361ه). النجف الأشرف 1423ه/ 2002م.
4 - زيد بن علي. العلامة الشيخ محمد رضا کاشف (11310ه/ 1366ه). تحقيق مؤسسة كاشف الغطاء العامة / النجف الأشرف. 1424ه / 2003م.
ص: 580
5 - الصوت وماهيته والفرق بين الضاد والظاء العلامة الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء (1310ه/ 1366ه). النجف الأشرف. 1421ه/ 2002م.
6 - العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (1294ه/ 1373ه). النجف الأشرف. 1421ه 2000م.
7- وثائق تاريخية للفاضل صلال (الموح). العلامة الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء (1310ه/ 1366ه). النجف الأشرف.
8- أحكام المتاجر. العلامة الشيخ مهدي كاشف الغطاء (1226ه / 1298م). النجف الأشرف. 1423ه/ 2003م.
9- رسالة في حجية الظن الشيخ علي كاشف الغطاء (1197ه / 1253ه)/. النجف الأشرف. 1423ه 2002م.
10 - نُبذة الغَري في أحوال الحسن الجعفري. العلامة الشيخ عباس كاشف الغطاء (1253 ه/ 1323ه ). النجف الأشرف. 1430 ه / 2009م.
11 - التعارض والتعادل والترجيح. آية اللّه العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء (1331 ه/ 1411ه). النجف الأشرف / 1430ه/ 2009م.
12 - باب مدينة علم الفقه وأدوار علم الفقه آية اللّه العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء (1331ه/ 1411ه). النجف الأشرف/ 1431 ه/ 2010م.
13 - القواعد الستة عشر / الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء (1156ه/ 1228م). النجف الأشرف. 1431ه/ 2010م.
14 - كشف ابن الرضا عن فقه الرضا الشيخ علي كاشف الغطاء (1331ه/
ص: 581
1411ه) /. النجف الأشرف (1432ه/ 2011م).
15 - مستدرك نهج البلاغة الشيخ هادي كاشف الغطاء (1290ه- / 1361ه- ). تحقيق مؤسسة كاشف الغطاء العامة. النجف الأشرف (1432ه/ 2011م).
16- مدارك نهج البلاغة ودفع الشبهات عنه. الشيخ هادي كاشف الغطاء (1290ه/ 1361ه). النجف الأشرف. (1432ه / 2011م).
وهناك عدة كتب الآن هي قيد التحقيق عسى أن تر النور قريبا إن شاء اللّه.
استحدث هذا القسم في عام (1997م / 1417ه) ليوفر لطلبة العلوم الدينية بعض الكتب المنهجية التي تدرس في حوزة النجف الأشرف.
ومن ثم توسع العمل في هذا القسم من خلال إدخال بعض المخطوطات على برنامج (word) وبغض النظر عن كونها محققة أم لا، فحتى عام 2004م تم تنضيد وإدخال أكثر من 100 مخطوطة كثير منها لم يحقق بعد، وقد طبع قرص خاص بهذه المؤلفات، وتم نشره وتوزيعه
كما بلغ عدد ما طبع من الكتب ونشر أو تم وضعه على برنامج (word) (108) كتاباً من كتب أسرة آل كاشف الغطاء العلمية.
ومن نشاطات القسم الأخرى تصميم البوسترات والنشرات الدينية لاسيما في أيام المناسبات الدينية، وتوزيعها على المؤمنين.
كانت النواة الأولى لهذه المكتبة ما تركه الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص: 582
(قدّس سِرُّه) قال ( ت 1228ه/ 1813م) الجد الأعلى لأسرة آل كاشف الغطاء، ثم انتقلت إلى الشيخ هادي كاشف الغطاء فأضاف إليها كتباً ومخطوطات فريدة فتضاعفت أعدادها بأضعاف مضاعفة، ومن ثم انتقلت إلى الشيخ محمد رضا فغذاها بنفائس الكتب، ومن بعده إلى المرحوم الشيخ علي آل كاشف الغطاء فحافظ عليها وأتحفها بما يفوق ضعف الأضعاف.
وكان قد أشار إليها دليل الجمهورية العراقية حيث كانت تحتوي على (5000) مجلد في مختلف المواضيع الدينية والأدبية واللغوية والتاريخية و (600) مخطوطة في وقت تأسيسها الأخير في مطلع القرن الرابع عشر الهجري على يد الشيخ هادي كاشف الغطاء، أما اليوم فقد أصبح مجموع كتبها يربو إلى (20,000) مجلد.
و من مزايا هذه المكتبة البارزة أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من المطبوعات القديمة النادرة التي هي اليوم بحكم المخطوطات.
وقد زُوِدت المكتبة ببرنامج إلكتروني تم إنشاؤه بإشراف متخصصين. وهذا البرنامج عبارة عن دليل عام الجميع كتب المكتبة، وفيه بلوغرافيا كل كتاب من اسم الكتاب والمؤلف والمحقق أو المترجم والموضوع والجزء واللغة والمطبعة ومكان وسنة الطبع ومصدر وتاريخ الاقتناء إضافة إلى رقم عام وخاص ورقم خزانة لكل كتاب، وأيضا أضيف لهذا البرنامج فكرة جديدة يستفاد منها الدارسون وطلبة العلوم وهي إضافة دليل المحتويات لكل كتاب، وأيضاً فيه إمكانية البحث داخل الفهارس، مما يسهل على الطلبة سرعة الوصول إلى المباحث العلمية.
والمكتبة مازالت مشرعة الأبواب وتستقبل الكثير من طلبة العلوم الدينية والدراسات الأكاديمية.
ص: 583
بادرت مؤسسة كاشف الغطاء العامة إلى استحداث قسم خاص باسم قسم المكتبة الالكترونية يأخذ على عاتقه تقديم التسهيلات للأخوة طلبة الحوزة العلمية والمحققين والباحثين والمثقفين وتقديم العون لهم والاستشارة في كيفية تشغيل تلك البرامج والاستفادة منها
وقد وفّر قسم المكتبة الالكترونية كل ما يحتاجه الباحث من أحدث البرامج المنتجة وأُعدت استمارات بالبرامج ليتمكن الباحث من تشخيص البرنامج الذي يلبي حاجاته.
الاستمارة الأولى : دليل لأقراص المخطوطات الذي أنتجه قسم الذخائر للمخطوطات.
الاستمارة الثانية : دليل للأقراص البحثية ونعني بها الأقراص التي تحوي مكتبات ضخمة مزودة بإمكانية البحث السريع مثلاً برنامج المعجم الفقهي الإصدار الثالث وبرنامج المعجم العقائدي وبرنامج جامع الأحاديث (نور 2) وغيرها الكثير الكثير، وفي مختلف الاختصاصات.
الاستمارة الثالثة : دليل لأقراص الدروس ونعني بها دروس المواد المتعارف دراستها في الحوزة العلمية كاللمعة والمكاسب ودروس في التفسير وغير ذلك.
الاستمارة الرابعة : دليل لأقراص البرامج العامة مثلاً برنامج الغدير وبرنامج الذكر الحكيم وبرنامج الموسوعة الطبيعية وبرنامج الموسوعة التاريخية وغيرها.
الاستمارة الخامسة : دليل لأقراص الأفلام الوثائقية والمناظرات العقائدية.
ولقد بلغ عدد أقراص المكتبة الالكترونية أكثر من (450) قرصاً ليزرياً ويوفر
ص: 584
القسم مجموعة من أجهزة الحاسوب المطورة مع ملحقاتها ليتمكن الباحث من استثمار تلك البرامج.
هذه هي أهم أقسام المؤسسة، وللمؤسسة أقسام أخرى كقسم البرامج الدينية، وقد بدأ العمل في هذا القسم عام 1417ه 1997م أيام حكم النظام الدكتاتوري، وبالإمكانيات الموفّرة، وقد أصدر عددا من البرامج تخص في غالبيتها حياة الأئمة المعصومين (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وقسم المؤتمرات والندوات والاحتفالات الدينية وقسم للانترنت:
تم افتتاح هذا القسم سنة 1423ه 2003م، وقد عمل القسم في أربعة اتجاهات:
الأول : الإشراف على موقع مؤسسة كاشف الغطاء العامة على شبكة المعلومات العالمية،
الثاني: تلبية طلبات الباحثين والمحققين من مختلف أنحاء العالم الذين يرومون الحصول على مخطوطات.
الثالث: فتح دورات تدريبية مجاناً لطلبة الحوزة العلمية حتى يتمكن الطالب من الاستفادة من شبكة المعلومات العالمية وهذه الدورات بإشراف متخصصين بهذا المجال.
الرابع: استقبال طلبة الحوزة العلمية والباحثين والاستفادة من شبكة المعلومات العالمية مجاناً، وبذلك تندفع المعوقات التي تقع مانعاً أمام طلبة العلوم الدينية كما حدث لكثير من الطلبة عند ارتيادهم الأماكن العامة فقد لا يجد الطالب الجو المناسب للتصفح فيها.
وقد تم تجهيز هذا القسم بأحدث أجهزة الحاسوب وتثبيت منظومة إنترنت كاملة وسريعة جداً خدمة للعلم والعلماء.
ص: 585
وللمؤسسة أيضا قسم يتولى الإشراف على الأوقاف التابعة للمؤسسة، وقسم للتبليغ، وقسم للمساعدات الخيرية. (ينظر الملحق الحادي والثلاثون)
ص: 586
أما وقد انتهى بي البحث إلى ما انتهى اليه، فإني لأرجو مخلصا أن أكون قد ألقيت ضوءا على حوزة النجف الأشرف العلمية، ماضيها الأصيل، وحاضرها المشرق الذي بات بفعل دور مرجعيتها العليا المؤثر، وكفاحها الأمين العادل، حاضرة اليوم في كل بيت وعلى كل لسان مهتم بالعراق في شرق الأرض وغربها.
وكيف لا تكون كذلك، وقد أرسى نضالها الفاعل، ودأبها الدائم، وعزمها الأكيد، دعائم دستور دائم للعراق، أصرت المرجعية العليا على أن تكتبه لجنة منتخبة من مجلس عراقي مختار في انتخابات عامة شاملة لا تستثني من جموع الشعب أحدا، ولا تعطي لورقة انتخاب أحد قوة تمثيلية فوق ورقة انتخاب أي أحد، وحين تلكأت قوات الاحتلال في إجابتها إلى ما تريد وتعللت بما بدا لها أن تتعلل به من أسباب واهية، وحجج زائفة فرضته المرجعية على محتلي أرضها،فرضا، بفعل مدّها الجماهيري الكاسح وعدالة طرحها الحازم وعزم إرادتها الراسخ، إنما بالحكمة، والحق والعدل والانصاف والسلم مادامت استعادة الحقوق، وتحقيق مطالب المواطنين سلما ممكنة، وفرص إنهاء الاحتلال من دون إراقة الدماء المعصومة معقولة وقابلة للتحقق.
فناضلت النضال كله ملزمة المحتلين بما ألزموا أنفسهم به، وقاومت المقاومة كلها ضد كتابة دستور بغير أيادي أهله، فخضع المحتلون لطرحها راغمين، وأذعنوا لمطلبها طائعين، متجر عين كأسه على مضض، راضین به علی کره، فكان لها ما أرادت من تحكيم إرادة العراقيين في إدارة شؤونهم بأنفسهم، وكان لها ما أحبت من تولي أمورهم بأيديهم،
ص: 587
سواء في انتخاب مشرعيهم، أو في اختيار حاكميهم، من دون تهميش لفئة دون فئة، ولا إقصاء لطائفة دون طائفة، خلافا لما اعتادت عليه الأغلبية العظمى الشيعية من شعبنا من تهميش لدورها، وإلغاء الخصوصياتها، حيث ظلت طوال تاريخها المعاصر مغيبة مضطهدة، مظلومة مهتضمة، بيد انها رغم ضراوة جلاديها، وقساوة جزاريها، وعسف حاكميها، أبية الإباء كله عزيزة العزة كلها، تتلوى على سياط جلاديها صابرة محتسبة دون أن تضعف أو تلين، وتكتوي بنار الإرهاب ممسية مصبحة دون أن تهادن أو تهون، بل بقيت ثابتة الخطى على طريقها رغم المحن والأرزاء، راسخة القناعة بحقوقها رغم المعاناة والضراء، لا تكاد تتنفس حتى تقمع، ولا تكاد تنهض حتى تكبح.
ومع ذلك كله بقيت جذوة قولة إمامها الحسين (هيهات منا الذلة) حية في ضميرها مشتعلة، نابضة بالحياة متجددة، لا تكاد تهدأ فورتها حتى تثور، ولا تكاد تخمد ثورتها حتى تتلهب، ولا يكاد لهيبها يخبو حتى يتأجج، إلى يعود الحق إلى نصابه، ويبزغ الفجر من مطلعه وإن طال السرى، واستوعر المسلك، واخشوشن المركب، وعزّ المطلب فعند الصباح يحمد القوم السرى.
ولقد آن للمرجعية الدينية بعد فراغها من انشغالها بالهم العام ودستوره، أن تعود فتضم اليه انشغالها بهم بيتها الخاص وتنظيمه تعيد توظيبه من جديد معززة من إيجابياته، ومعاودة النظر في سلبياته، ناظرة به إلى أبعد من حاضره، كي تعبر به الحاضر الراهن، وتعده للغد الآتي، وهو أكثر وعيا لاستشراف المستقبل، وأقوى أساسا، وأوطد أركانا وأحكم بنيانا، وأحدث أثاثا، وأجد أداة، وأكفأ نظاما، وأوسع أفقا، وأشمل خطة، لما هو كائن اليوم، فإنها على ذلك أقدر، وبه أولى، ومَن غيرها أولى بها منها، ومَن غيرها أحرص عليها منها، فقد عودتنا حكمتها ودرايتها، وحسن معالجتها للأمور وحنكتها، ما أطمعنا منها بالمزيد، وها أنذا أستذكر روادها المصلحين، مراجع وباحثين،
ص: 588
فإن وجدت ما وجدت من حاجة ملحة للتطوير تلبية لمتطلبات الحاضر واستشرافا للغد الآتي:
إن ثقة حوزتنا المطلقة بالله عز وجل، وتفويضها أمرها اليه، واتكالها الدائم عليه، وحسن ظنها به ثم رعاية إمامها المنتظر (عَجَّلَ اللّهُ تَعَالَي فَرَجَهُ الشَریف) لها، ومعرفته بصدق نواياها، وتأييده لخير مشاريعها، وتسديده لمسير خطواتها، وتقويمه لمشكل،أمورها، ما يكفل لها تحقيق ما تصبو اليه، ويطمئن المؤمنون عليه. فقد توكّل اللّه لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة. والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون، ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون، حيّ لا يموت.
صدق أمير المؤمنين وولي المتقين. والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلواته على رسوله وأهل بيته ابدا وسلامه دائما سرمدا.
ص: 589
ص: 590
فيما يأتي فهرست لملاحق الكتاب وهي:
1 - الملحق الأول : صور حديثة للعتبة العلوية المشرفة.
2 - الملحق الثاني: أساتذة حوزة النجف الأشرف يلقون بحوثهم على طلبتهم في رحلتي المقدمات والسطوح في المسجد الهندي في النجف الأشرف في النصف الأول من هذا العام 1433 ه/ 2012م.
3- الملحق الثالث: صورتان لطريقة تدريس البحث الخارج في حوزة النجف الأشرف في النصف الثاني من القرن الماضي: أولاهما لسماحة المرجع الأعلى في وقته الإمام السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه)، وثانيهما لسماحة المرجع الأعلى في وقته السيد أبو القاسم الخوئي (قدّس سِرُّه)، ولا زالت الطريقة نفسها متبعة اليوم. تنظر (الملاحق: السابع والثامن والتاسع وأمثالها) أيضا.
4 - الملحق الرابع: صورتان لإجازتي اجتهاد المرجع الأعلى الحالي سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه).
5- الملحق الخامس : سماحة الشيخ باقر الإيرواني يلقي بحثه على مستوى البحث الخارج بحسينية المدرسة الغروية الملحقة بالصحن العلوي الشريف (سنة 1433ه/ 2012م).
6 - الملحق السادس : سماحة الشيخ محمد سند يلقي بحثه على مستوى البحث
ص: 591
الخارج على طلبته في مسجد عمران بن شاهين في النجف الأشرف أواسط سنة 1433ه/ 2012م
الملحق السابع: سماحة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم يلقي بحثه على مستوى البحث الخارج في علم الفقه بمكتبه العامر في النجف الأشرف سنة 1433ه/ 2012م.
8- الملحق الثامن : سماحة المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض يلقي بحثه على مستوى البحث الخارج في علم أصول الفقه بمكتبه العامر في النجف الأشرف سنة 1433ه/ 2012م.
9 - الملحق التاسع: سماحة المرجع الشيخ بشير النجفي يلقي بحثه على مستوى البحث الخارج بمكتبه العامر في النجف الاشرف سنة 1433 ه/ 2012م.
10 - الملحق العاشر صور أشهر مراجع التقليد في حوزة النجف الأشرف الحالية وهم: أصحاب السماحة كل من : المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه). والمرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه). والمرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام ظلّه). والمرجع الشيخ بشير النجفي دام (ظلّه).
11 - الملحق الحادي عشر : معاناة مرجعية النجف الأشرف حوزتها العلمية جراء دكتاتورية وطائفية نظام العهد البائد في الثمانينات وما بعدها، وخاصة بعد انتفاضة شعبان (1411 ه/ آذار 1991 م).
12 - الملحق الثاني عشر : إحصائية أولية ب (أساتذة البحث الخارج) من غير المراجع، و(أساتذة السطوح العالية : المكاسب والكفاية) في حوزة النجف الأشرف لسنة 1433ه/ 2012م ).
ص: 592
13 - الملحق الثالث عشر : صورة الدراسة في (حسينية المدرسة الغروية) الملحقة بالصحن العلوي الشريف، ويلاحظ سماحة الشيخ محمد هادي آل راضي يلقي بحثه في مرحلة البحث الخارج على طلابه سنة 1433 ه / 2012م.
14 - الملحق الرابع عشر : صورة الدراسة في إحدى غرف الصحن العلوي التي ضمت أجداث كبار علماء حوزة النجف الأشرف، ويشاهد سماحة السيد محمد صادق الخرسان يلقي بحثه على طلابه في مرحلة السطوح العليا سنة 1433ه / 2012 م.
15 - الملحق الخامس عشر : صورة الدراسة في جامع عمران بن شاهين، ويشاهد سماحة الشيخ محمد سند يلقي بحثه على طلابه في مرحلة البحث الخارج سنة 1433ه/ 2012م.
16 - الملحق السادس عشر صورة الدراسة في جامع الخضراء ومقبرة السيد الخوئي (قدّس سِرُّه)، ويشاهد سماحة السيد علاء الموسوي الهندي يلقي بحثه على مستوى السطوح العليا ( عام 1433ه / 2012 م).
17 - الملحق السابع عشر : صورة الدراسة في جامع الشيخ الطوسي في النجف الأشرف، ويشاهد سماحة السيد جعفر السيد عبد الصاحب الحكيم يلقي بحثه على طلابه في مرحلة السطوح العليا سنة 1433 ه / 2012م.
18 - الملحق الثامن عشر : صور الدراسة في جامع الجواهري ويشاهد في الصورة سماحة الشيخ حسن الجواهري يلقي بحثه على طلابه في النجف الأشرف سنة 1433 ه/ 2012م.
19 - الملحق التاسع عشر : صور الدراسة في مرحلتي المقدمات والسطوح، وتشاهد حلقاتها في المسجد الهندي في النجف الأشرف سنة 1433 ه/ 2012م.
ص: 593
20 - الملحق العشرون: صور الدراسة في مقبرة علماء أسرة آل الحكيم المتصلة بالمسجد الهندي في النجف الأشرف، ويشاهد سماحة السيد حسين الحكيم يلقي بحثه على مستوى السطوح العالية سنة 1433 ه/ 2012م.
21 - الملحق الحادي والعشرون: صورة الدراسة في (الحسينية الأعسمية)، ويشاهد سماحة السيد أحمد الإشكوري يلقي بحثه على مستوى السطوح العالية سنة 1433ه/ 2012م.
22 - الملحق الثاني والعشرون: صور الدراسة في ( حسينية آل محي الدين)، ويشاهد سماحة السيد رشيد الحسيني يلقي بحثه على مستوى السطوح العليا سنة 1433ه / 2012م.
23- الملحق الثالث والعشرون: صورة للدراسة في البيوت والمكاتب ويشاهد سماحة السيد أحمد الصافي يلقي بحثه على مستوى السطوح العليا سنة 1433ه/ 2012م.
24 - الملحق الرابع والعشرون صورة كتاب منح درجة الأستاذية لسماحة آية اللّه العلامة السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) سنة 1384ه/ 1964م.
25 - الملحق الخامس والعشرون صورة كتاب انتخاب سماحة آية اللّه المجدد السيد محمد تقي الحكيم قتل عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1387ه/ 1967. م.
26 - الملحق السادس والعشرون : إحصائيات مستفادة من أعداد الطلبة المسجلين والمشاركين في امتحانات حوزة النجف الأشرف للسنوات الست الماضية : (1426- 1431 ه/ 2005 - 2010م).
ص: 594
27 - الملحق السابع والعشرون: صورة لطلاب مدرسة الإمام الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) سنة 1432ه / 2011م.
28- الملحق الثامن والعشرون: صورة لطلاب مدرسة دار الحكمة للبنين سنة 1433 ه/ 2012 م.
29 - الملحق التاسع والعشرون: نتائج استبيان العنف ضد المرأة سنة 1430ه/ 2009م.
30- الملحق الثلاثون: صورة لمؤسسة زين الدين تدل للمعارف الإسلامية سنة 1432ه/ 2011م.
31- الملحق الحادي والثلاثون: صورة لمؤسسة الإمام كاشف الغطاء العامة سنة 1433ه/ 2012 م.
ص: 595
الصورة
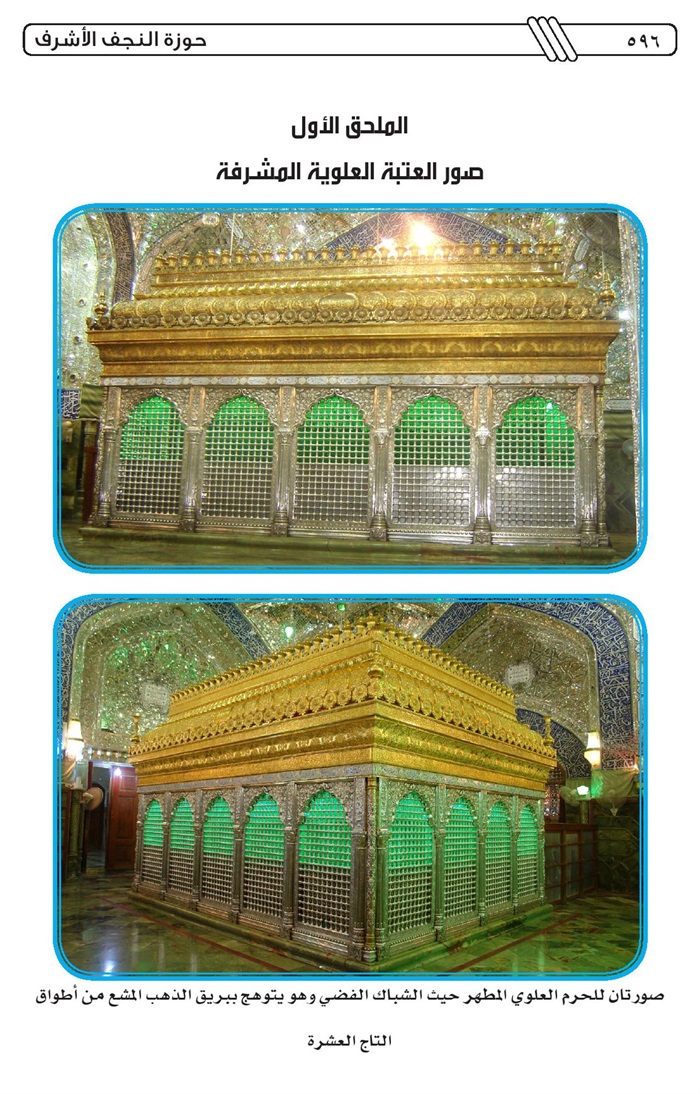
ص: 596
الصورة
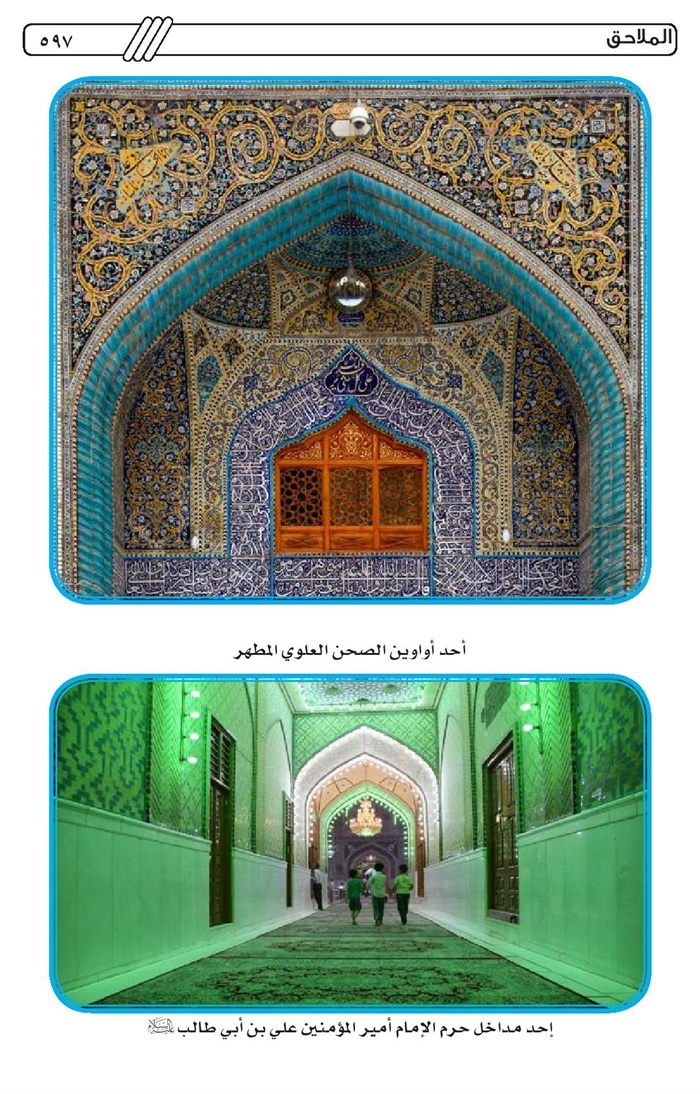
ص: 597
الصورة
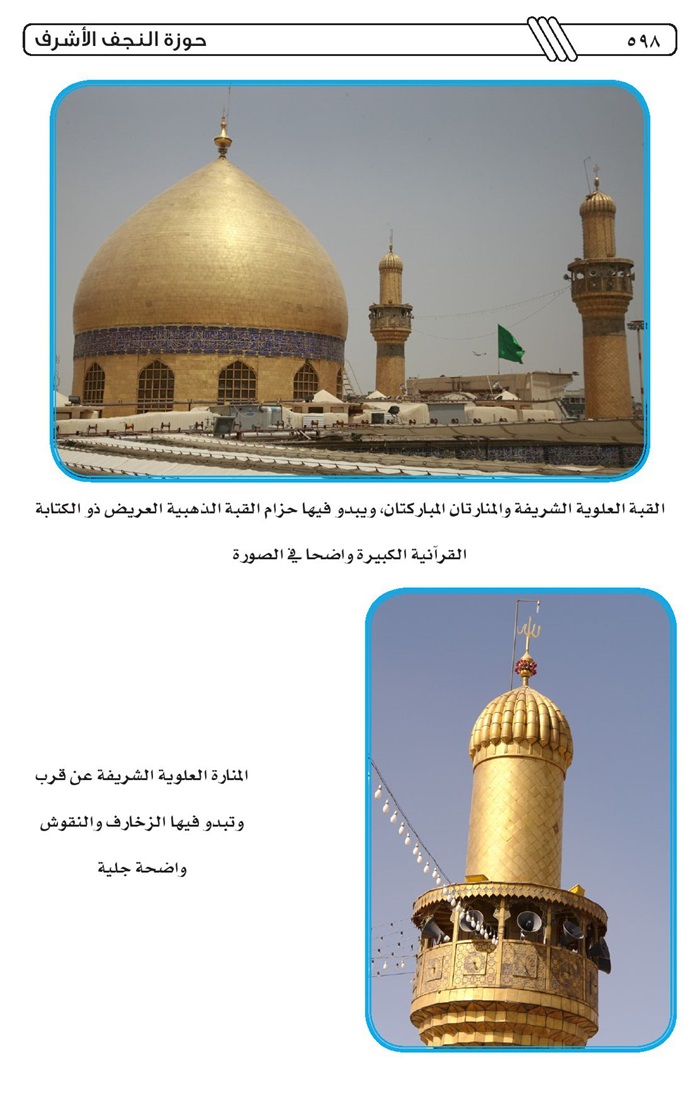
ص: 598
الصورة
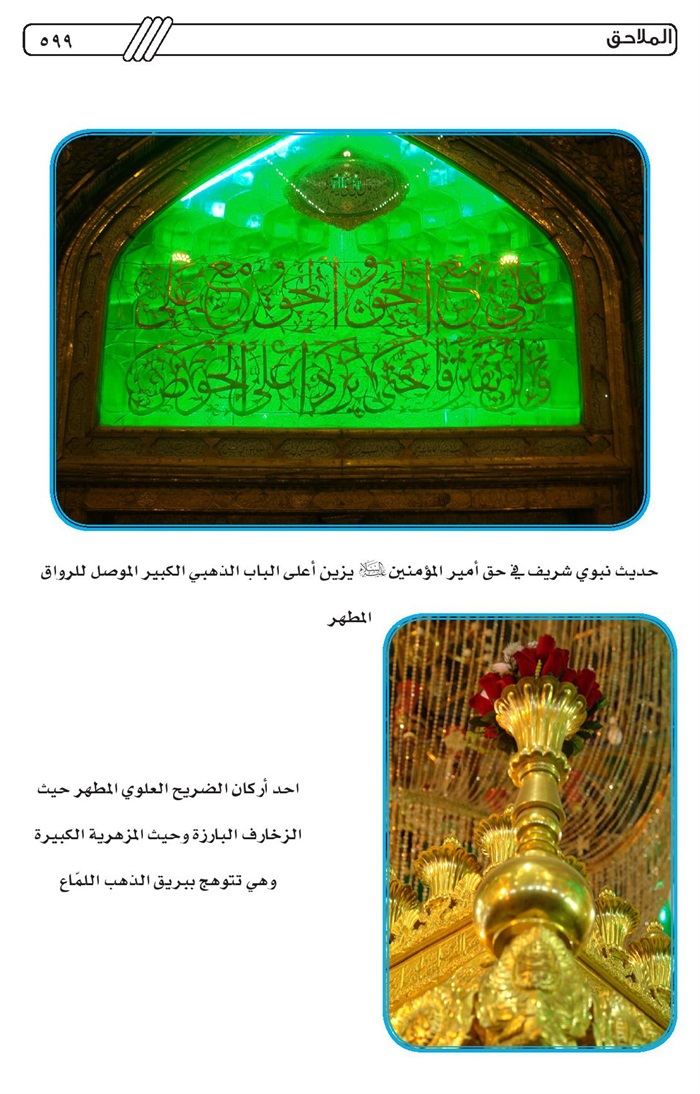
ص: 599
الصورة
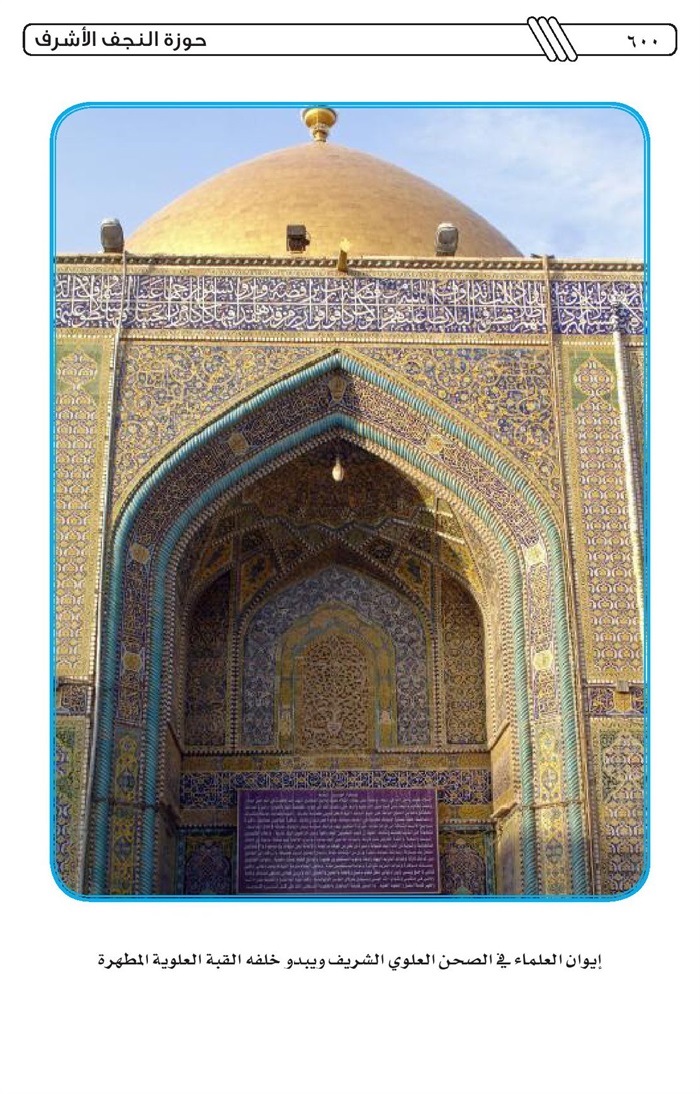
ص: 600
الصورة

ص: 601
الصورة

ص: 602
الصورة
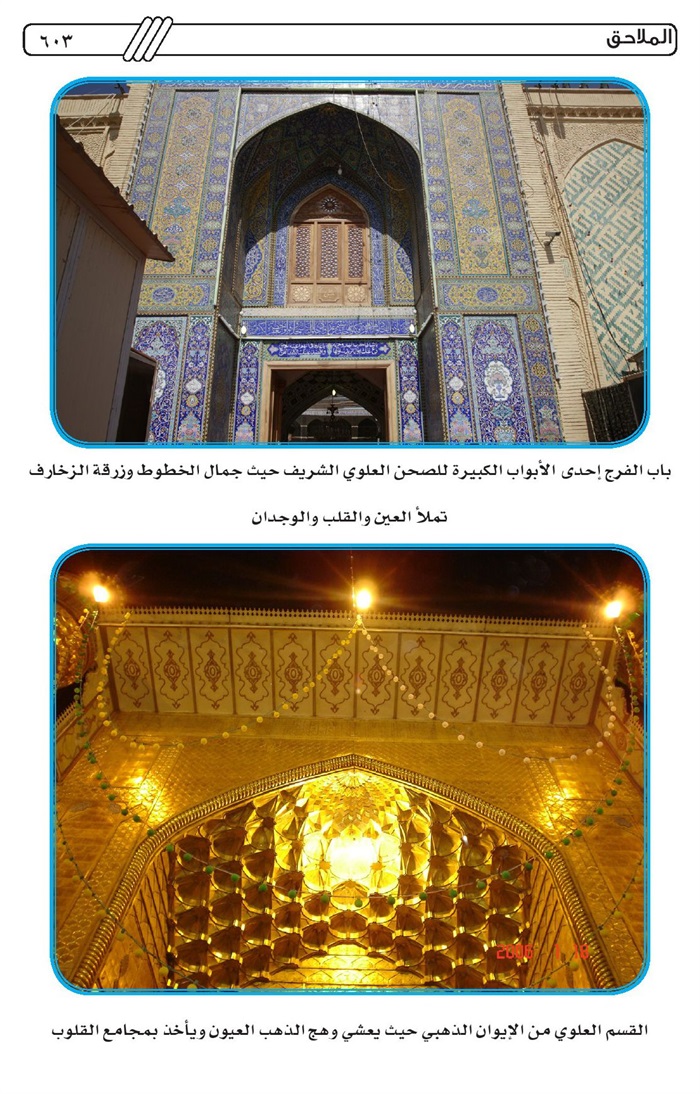
ص: 603
الصورة
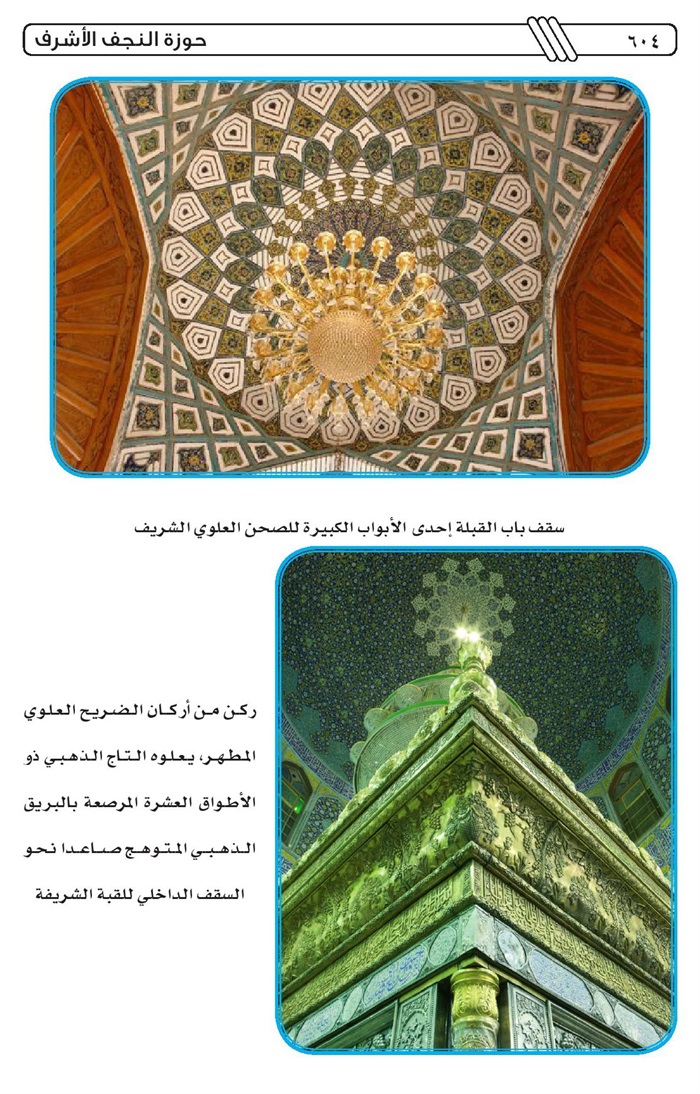
ص: 604
الصورة
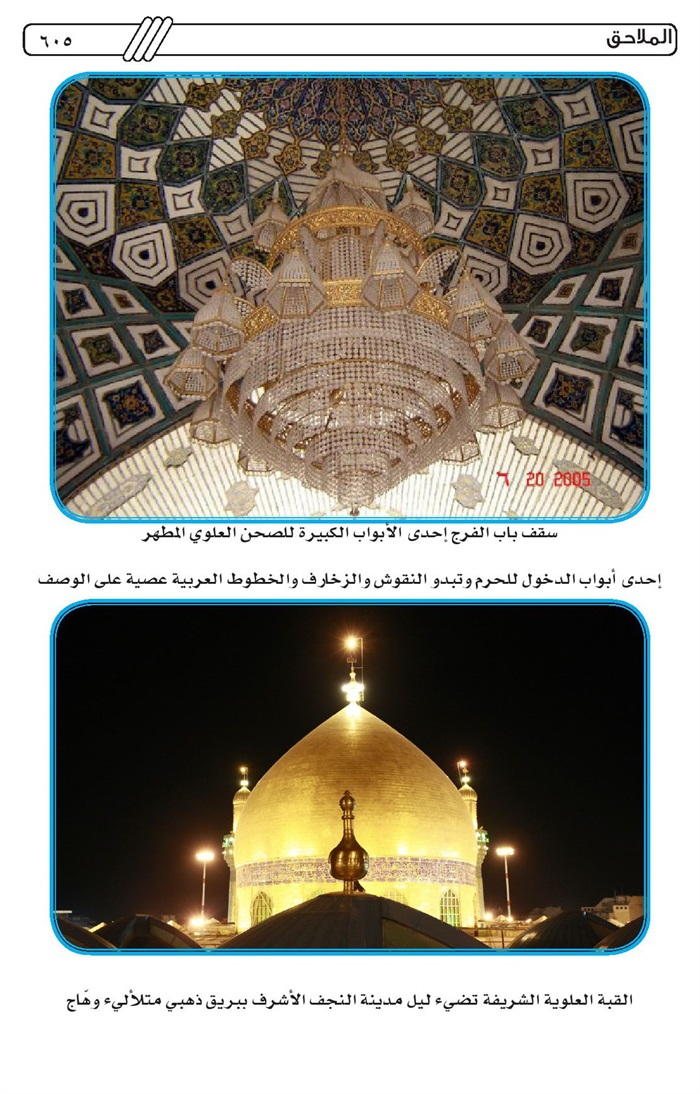
ص: 605
الصورة
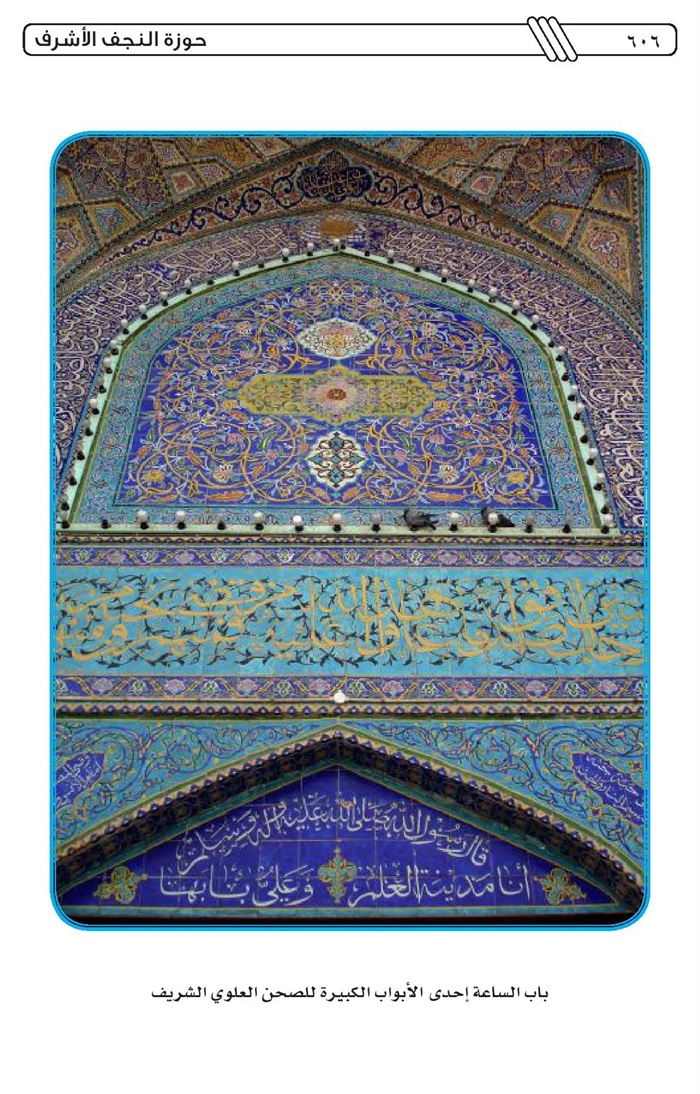
ص: 606
الصورة
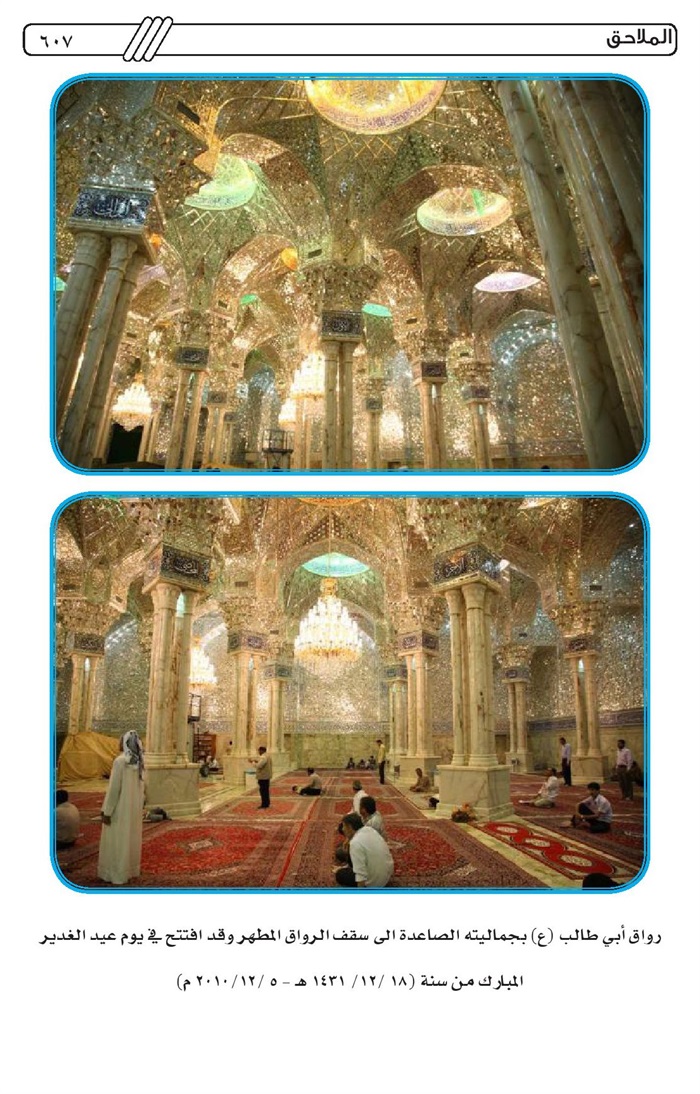
ص: 607
أساتذة حوزة النجف الأشرف يلقون بحوثهم على طلبتهم في مرحلتي المقدمات والسطوح في المسجد الهندي في النجف الأشرف في النصف الأول من عام 1433ه/ 2012م (صور خاصة)
الصورة

ص: 608
صورتان لطريقة تدريس البحث الخارج في حوزة النجف الأشرف في النصف الثاني من القرن الماضي : أولاهما لسماحة المرجع الأعلى في وقته الإمام السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه)، وثانيهما لسماحة المرجع الأعلى في وقته السيد أبو القاسم الخوئي (قدّس سِرُّه)، ولا زالت الطريقة نفسها متبعة اليوم. تنظر (الملاحق : السابع والثامن والتاسع وأمثالهما) أيضاً.
الصورة

ص: 609
صورتان لإجازتي اجتهاد المرجع الأعلى الحالي سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) ممنوحتان له من قبل أستاذيه : الصورة الأولى صورة شهادة الاجتهاد الممنوحة من قبل المرجع الأعلى في وقته سماحة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، والصورة الثانية صورة شهادة الاجتهاد الممنوحة من قبل آية اللّه العظمى سماحة الشيخ حسين الحلي (قدس اللّه سريهما).
الصورة
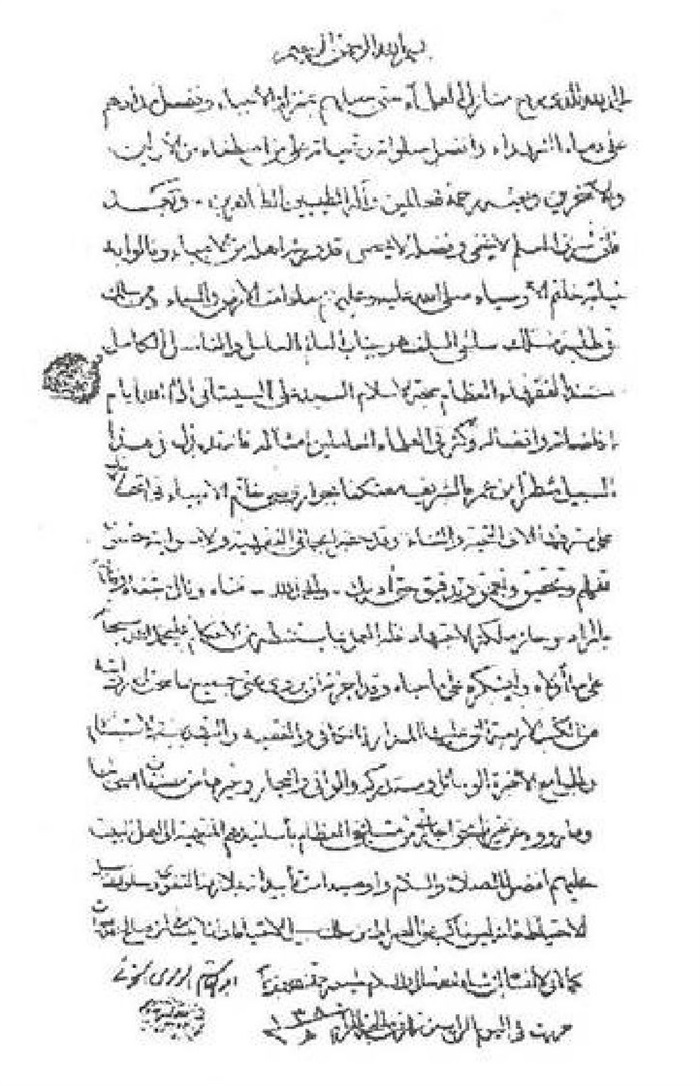
ص: 610
الصورة
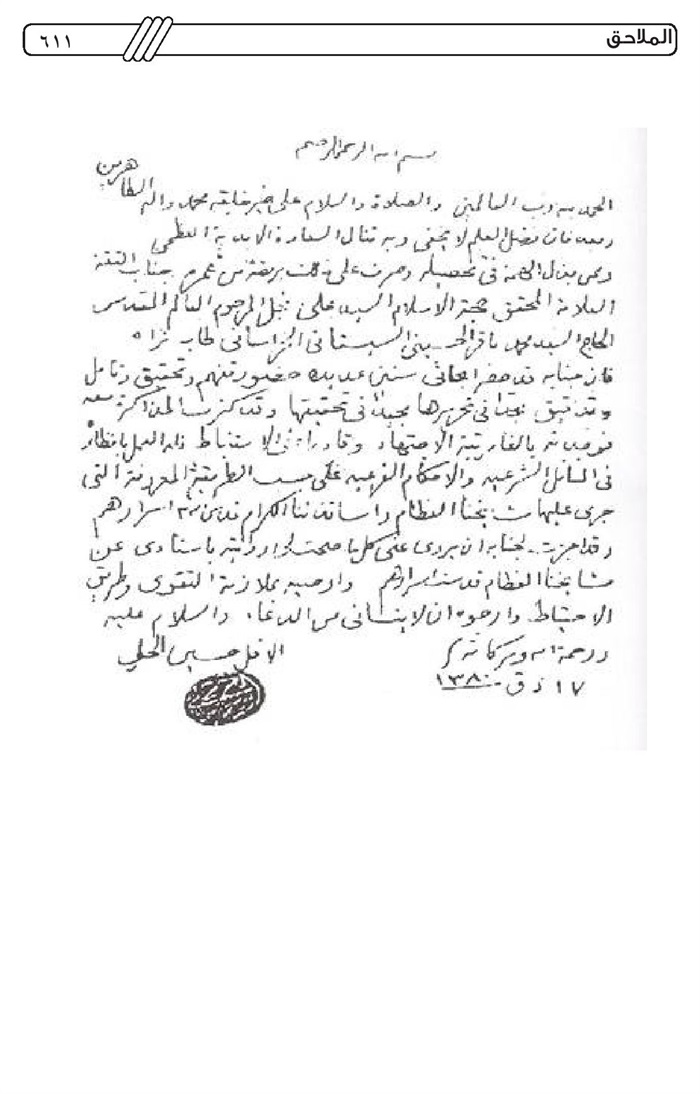
ص: 611
سماحة الشيخ باقر الإيرواني يلقي بحثه على طلبته بمرحلة البحث الخارج في حوزة النجف الأشرف، وذلك في حسينية المدرسة الغروية الملحقة بالصحن العلوي الشريف سنة 1433ه/ 2012 م. (صورة خاصة)
الصورة

ص: 612
سماحة الشيخ محمد سند يلقي بحثه على مستوى البحث الخارج على طلبته في مسجد عمران بن شاهين في النجف الأشرف أواسط سنة 1433ه/ 2012م. ( صورة خاصة)
الصورة

ص: 613
سماحة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه)
يلقي بحثه على مستوى البحث الخارج في مادة الفقه الإسلامي على طلبته في مكتبه العامر أواخر (عام 1432 / 2011م). (صور خاصة)
الصورة

ص: 614
سماحة المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام ظله)
يلقي بحثه على مستوى البحث الخارج في مادة أصول الفقه على طلبته في مكتبه العامر أواسط عام 1432 /2011م). (صور خاصة)
الصورة

ص: 615
سماحة المرجع الشيخ بشير النجفي يلقي بحثه على مستوى البحث الخارج بمكتبه العامر في النجف الأشرف سنة 1433ه / 2012م. (صور خاصة)
الصورة

ص: 616
الصورة

ص: 617
صور أشهر مراجع التقليد في حوزة النجف الأشرف الحالية
الصورة

ص: 618
معاناة مرجعية النجف الأشرف وحوزتها العلمية جراء دكتاتورية وطائفية نظام العهد البائد في الثمانينات وما بعدها، وخاصة بعد انتفاضة شعبان 1411ه آذار 1991م.
سأتناول معاناة المرجعية وحوزة النجف الأشرف من خلال نقاط عدة أبرزها:
منذ أن بدأت المرجعية الدينية والحوزة العلمية تصديها الحازم للحكام المنحرفين استمر تنكيل السلطات بها وبخاصتها وأتباعها و مريديها بين سجن وتسفير، وإعدام وتهجير، واستباحة للأنفس و الأموال والثمرات، وهتك للحرمات، ما يطول ذكره ويصعب وصفه.
وسيتوقف تاريخ العراق طويلاً أمام تصدي مراجع النجف الاشرف للحكام الظالمين والطغاة المجرمين، وما تحملوه جرّاء ذلك الموقف من عنت وجور ما سيظل شاهداً على جسامة مهمة المرجع الديني وما يتطلبه دوره الديني والإصلاحي والسياسي والاجتماعي من تحديات وتضحيات تقتضيها زعامته الدينية ومرجعيته العامة للأمة التي ألقت بزمامها إليه وأناطت أمورها به.
منذ أن تسلم حزب البعث مقاليد السلطة في العراق بواسطة انقلاب عسكري حتى قرران من أولى أولوياته من أجل إدامة تشبثه في السلطة تحطيم المرجعية الشيعية أو تحجيمها وتقليص نفوذ زعامتها الشعبية الكبيرة المتمثلة حينها بالمرجع الأعلى في عصره
ص: 619
سماحة الإمام السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه).
وقد بدأت تنفيذ ما قررته بالفعل في العامين (1389/1969 ه) و ( 1970 / 1390ه) حيث ضيقت أجهزة الدولة الخناق عليه وزادت في تعديها فاتهمت نجله الشهيد لاحقاً السيد مهدي الحكيم بالعمالة وحكمت عليه ظلماً بالإعدام غيابياً، ثم بدأت بملاحقة مريدي المرجعية الدينية والمتدينين، فأمرت بالتسفير القسري مرة أخرى في عام (1391/1971ه).
وفي يوم (1394/1974/12/5 ه) نفذ حكم الإعدام بعدد من طلاب وأساتذة الحوزة العلمية في النجف.
وفي شهر تموز – يوليو - من العام نفسه هجَّرت مفارز الأمن والاستخبارات والشرطة وقوى الأمن العراقية الأخرى بالقوة آلافاً من العوائل العراقية، بينها العديد من أساتذة حوزة النجف الأشرف العلمية وطلابها واحتجزت شبابها في السجون، ولم يعرف حتى اليوم كيف أعدمتهم السلطات الجائرة، ومتى وأين دفنوا؟.
كما ألغت سمات الإقامة لطلاب الحوزة العلمية وأساتذتها من غير العراقيين.
وفي العام 1975 / 1395ه اعتقلت مفارز الأمن ما يقارب من مائة أستاذ ومدرس وطالب في صفوف الحوزة العلمية في النجف الأشرف.
وفي الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني - نوفمبر - من السنة نفسها اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر م ألف ومائتين وخمسين من علماء الحوزة العلمية وأساتذتها في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.
وفي ليلة التاسع من نيسان - إبريل من (عام 1980/ 1400ه) تم تنفيذ حكم الإعدام بسماحة المرجع الديني السيد محمد باقر الصدر (قدّس سِرُّه).
ص: 620
وفي أوائل الثمانينات تم اعتقال العديد من المجتهدين وأساتذة الحوزة العلمية من أمثال أصحاب السماحة الشيخ محمد تقي الجواهري عضو لجنة الاستفتاء في مكتب المرجع الأعلى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه)، وكذلك الشيخ هاشميان، والشيخ أحمد الأنصاري.
وفي (عام 1403/1983ه) تعرضت سيارة المرجع الديني الأعلى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي نفسه إلى حادثة تفجير نجا منها بعناية(1).
بعدها اقترفت السلطات جريمة إعدام السيد محمد تقي الجلالي.
وباختصار فقد أثبت المقرر الخاص للامم المتحدة للجنة حقوق الإنسان في العراق مارك فان دير شتويل في تقريره بعضاً مما عانته الحوزة العلمية في النجف الأشرف قبل الانتفاضة الشعبانية العارمة في (شعبان 1411 ه/ آذار 1991م) فلاحظ خلال زيارته لمدينة النجف الأشرف في (كانون الثاني - يناير - 1412/1992ه-) تقلص عدد رجال الدين في النجف من ( 8000 أو 9000) قبل عشرين عاماً مضت إلى (2000) قبل عشر سنوات والى (800) قبل الانتفاضة.
ومن الناحية العملية فهم إما معتقلون أو مختفون كما يقال، وان النظام البعثي يريد تحطيم الثقافة الشيعية وذلك بإنهاء القيادة التقليدية لطبقة العلماء. (2).
إن قراءة أولية لعذابات هذه الأسرة العلمية العراقية من خلال اعتقالها (سنة 1993م / 1413ه) تلقي الضوء على ما عانته أسر حوزة النجف الأشرف العلمية العريقة زمن النظام البائد وهي أسر كثيرة لا يمكنني تتبع عذاباتها الكبيرة والكثيرة
ص: 621
والمتنوعة، بيد اني سآخذ هذه الأسرة العلمية أنموذجا على معاناة أسر هذه الحوزة العلمية ذات الألف عام.
إن القراءة الأولية لعذابات هذه الأسرة العلمية تنتهي بنا الى ما يأتي:
1 - في ليلة ( 26/ رجب / 1403ه / 10 / 5 / 1983م ) تمت مداهمة بيوت أسرة آل الحكيم العلمية في ليلة واحدة في ساعة واحدة، تحت تهديد السلاح، ليعتقل أغلب رجالها، وتترك النساء والأطفال دون معيل لسنوات عدة.
2- جرت عملية المداهمة والاعتقال دون مذكرات قضائية ودون تهم محددة،
3- لقد كان كل ذنب المعتقلين أنهم من أقارب معارضين سياسيين ناشطين خارج العراق، كما ورد في الكتب الرسمية الموثقة.
- لقد اعتقل من هذه الأسرة ومن طلبة العلوم الدينية وحدهم دون غيرهم (اثنان وخمسون) طالب علم، تنوعت مستوياتهم العلمية من مجتهدين مرشحين للمرجعية، الى مقاربين للاجتهاد، الى أساتذة حوزة كبار، الى فضلاء الى وطلاب مبتدئين.
- اقترافت جريمة إعدام المجموعة الأولى من الأسرة عام (1403/1983ه) وفيها من المجتهدين وأساتذة الحوزة العلمية وفضلائها الشهداء السادة : عبد الصاحب، وعلاء الدين محمد حسين من أنجال الإمام الحكيم، وكمال الدين، وعبد الوهاب من أحفاد الإمام الحكيم.
- تم إعدام المجموعة الثانية من الأسرة عام (1985 م/ 1405ه) وضمت علماء في الحوزة العلمية وأساتذتها ومنهم كل من الشهداء السادة : مجيد الحكيم، وعبد الهادي نجل الإمام الحكيم ومحمد رضا، وعبد الصاحب من أنجال آية اللّه الحجة السيد محمد حسين الحكيم (قدّس سِرُّه) الذي سفر بالقوة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، والسيد حسن
ص: 622
من أحفاد الإمام الحكيم، بالإضافة إلى إعدام السيد محمد حسن نجل آية اللّه الحجة السيد محمد علي الحكيم (قدّس سِرُّه) بحقنة قاتلة.
- تم وضع عدد من كبار مجتهدي الأسرة وعلمائها المعروفين قيد الاقامة الجبرية في بيوتهم لسنوات بعد اعتقالهم واطلاق سراحهم مع وضع نقطة مراقبة أمنية تضم مفرزة مسلحة ترابط ليل نهار على باب دار كل منهم، وهؤلاء السادة هم : آية اللّه السيد يوسف الحكيم، واية اللّه السيد محمد علي الحكيم، وآية اللّه المصلح السيد الوالد محمد تقي الحكيم، وآية اللّه السيد محمد رضا الحكيم الذي اعتقل ثانية بعد الانتفاضة ثم اعدم لاحقاً، والسيد جواد نجل آية اللّه السيد محمود الحكيم (قدس اللّه أسرارهم).
- استكمالاً لتحجيم دور الأسرة الديني والتربوي والجماهيري تم حجز العشرات من افرادها رهائن تحت تهديد الإعدام لسنين بمن فيهم العديد من العلماء وأساتذة الحوزة العلمية والمدرسين والفضلاء.
- من معتقلي الأسرة آية اللّه المقدس السيد يوسف الحكيم (قدّس سِرُّه) الذي اعتقل عمّا يقارب الثمانين سنة له من الشهداء: سبعة إخوة، وولدان، وحفيدان، وأربعة أسباط، اعتقل هو مع أربعة من أولاده، واثنين من أحفاده، وأربعة من أسباطه.
- من بين معتقلي الأسرة آية اللّه السيد محمد علي الحكيم (قدّس سِرُّه) الذي أعتقل عن ثلاث وسبعين سنة، واعتقل معه أبناؤه وأبناء أبنائه، وعددهم خمسة عشر معتقلا دفعة واحدة.
- ومنهم الوجيه السيد مهدي السيد باقر الحكيم الذي اعتقل واعتقلت معه زوجته وابنته وأولاده الثلاثة (أحدهم عمره سبع سنوات)، وأعدم هو وزوجته،وولداه، وابنته ذات الأربعة عشر ربيعاً.
من معتقلي الأسرة أحداث دون السن القانوني كالسادة : جعفر السيد عبد
ص: 623
الصاحب ( 17 سنة )، وحسين السيد علاء الدين، وهاشم السيد محمد تقي (16 سنة)، وميثم السيد عبد الرزاق وهادي السيد محمد جواد، وهادي السيد محمد حسين (15 سنة )، ورضا السيد كاظم، وعلي السيد عبد الهادي (13 سنة ) وغيرهم.
- ومن معتقليها كذلك أب وأبنه كآية اللّه السيد محمد تقي السيد سعيد (قدّس سِرُّه)، وأب وابناه كحجة الإسلام والمسلمين السيد محمد جعفر السيد محمد صادق، وأب وثلاثة أبناء كحجة الإسلام المقدس السيد محمد تقي السيد محمد علي، وأب وأربعة أبناء كآية اللّه العظمى المرجع الكبير السيد محمد سعيد السيد محمد علي، وآية اللّه العلامة السيد محمد حسين السيد سعيد، والوجيه الكبير السيد محمد جواد السيد محمود.
- من هذه الأسرة أبناء لشهداء لم يروا آباءهم، لأنهم ولدوا بعد استشهادهم كالسيد علي السيد كمال الدين.
- منهم شهداء متزوجون انقطع نسلهم من الذكور كالسيد عبد الصاحب السيد محمد حسين، والسيد أحمد السيد محمد رضا.
- ومنهم من استشهد هو وواحد من أبنائه كحجة الإسلام والمسلمين السيد محمد رضا نجل المرجع الأعلى في وقته الإمام السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه).
- ومنهم من استشهد ومعه اثنان من أبنائه كأخيه حجة الإسلام الدكتور السيد عبد الهادي، وحجة الإسلام والمسلمين السيد مرتضى السيد محمد علي، وحجة الإسلام السيد كمال الدين السيد يوسف
- ومن شهداء هذه الأسرة : أخوان شهيدان كالسيدين يحيى وعبد الأمير السيد حسن والسيدين هاشم وحسن السيد محسن.
- ومنهم ثلاثة إخوة شهداء كالسادة محمد،رضا ومحمد، أنجال السيد محمد
ص: 624
حسين.
ومنهم سبعة إخوة شهداء كالسادة العلماء السيد محمد رضا والسيد مهدي، والسيد محمد باقر، والسيد عبد الهادي والسيد عبد الصاحب والسيد علاء الدين والسيد محمد حسين أنجال الإمام السيد محسن الحكيم (قدّس سِرُّه).
ومنهم من قضى نحبه نتيجة الظروف القاسية التي عانتها الأسرة في السجن كحجة الإسلام السيد حسن السيد محمد علي، والسيد غياث الدين السيد جاسم.
- ومن هذه الأسرة أخيرا وليس آخرا سماحة آية اللّه العلامة السيد محمد حسين الحكيم (قدّس سِرُّه) الذي أحضر من زنزانته ليشهد بأم عينيه عمليات إعدام أهله شهيدا إثر شهيد، وكان كلما أغمي عليه إثر عملية إعدام وحشية ترك ليفيق كي يشهد عملية الإعدام اللاحقة وهكذا. ولم يكتف المجرمون بذلك بل أعدموا لاحقا أبنائه الثلاثة دفعة واحدة.
ومنهم ومنهم ومنهم، ولو شئت أن أحصي لاحتجت الى وقت أطول.(1)
لقد استمرت السلطة الظالمة في ملاحقة رجالات الحوزة الحوزة العلمية واضطهادهم. ففي (عام 1985م/ 1405ه ) فتم اغتيال صهر المرجع الاعلى في عصره السيد الخوئي (قدّس سِرُّه)، وهو آية اللّه السيد نصر اللّه المستنبط عن طريق زرقه بحقنة قاتلة.
- وفي (1988/1/17) اغتالت المخابرات السيد مهدي الحكيم (قدّس سِرُّه) في باحة فندق هيلتون في العاصمة السودانية الخرطوم على يد دبلوماسي عراقي يعمل في السفارة العراقية في السودان.
ص: 625
وغير ذلك كثير مما يصعب احصاؤه أو استقصاؤه في هذا المختصر.
لقد تجشمت النجف الأشرف جراء هذه المواقف وأمثالها ما تجشمت، كما تجشم المراجع العظام وغيرهم من الفقهاء الابرار وطلاب الحوزة العلمية واساتذتها والاسر الدينية وعموم المؤمنين والصالحين من مريديهم ما تجشموا من بلاء وظلم وعنت وجور وقهر حكامهم الظلمة، ما سيظل شاهداً على ما قدمته النجف وحوزتها العلمية ومريديها من المؤمنين في سبيل احقاق الحق وازهاق الباطل من ادوار مضمخة بالدماء والتضحيات الكثيرة.
وحسبك ان تعرف ان الحكام الظالمين، وبعد فشل الانتفاضة الجماهيرية الكبرى في عام 1411ه/ 1991م، استعملوا النار والحديد، فقد اقتحمت قوات النظام السابق مدينة النجف الاشرف واقتادت سماحة المرجع الأعلى في عصره سماحة آية اللّه العظمى السيد أبو القاسم الخوئي (قدّس سِرُّه) وقد ناهز الخامسة والتسعين من العمر، تحت تهديد السلاح من بيت نجله الشهيد السعيد السيد محمد تقي في النجف الاشرف الذي كان مقراً للقيادة الدينية والعسكرية للإنتفاضة إلى بغداد، صحبة ولديه الكريمين السيد محمد تقي الذي اغتيل في حادث مدبر لاحقاً، والسيد ابراهيم مع جميع مساعدي السيد المرجع، ومعهم العشرات من أفضل والعلماء والأساتذة في الحوزة العلمية النجفية، ليحتجزوا هناك ليجبر الطاغية المرجع الأعلى مع نجله السيد محمد تقي على اجراء مقابله قسرية معه، ثم ليقترف جريمة تنفيذ حكم الاعدام بالعلماء المعتقلين الباقين ودفنهم في مكان مجهول لم يكتشف موقعه حتى اليوم.
بالاضافة إلى تنكيل صدام وزبانيته بالمرجع الديني السيد عبد الاعلى السبزواري (قدّس سِرُّه)
ص: 626
وانجاله وقد توفي لاحقاً بشكل يثير الريبة والتساؤل.
يقول المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة (ماكس فإن دير شتويل) في تقريره عن الوضع في العراق بعد الانتفاضة الشعبانية ما نصه فما بين (19 - من آذار - مارس 1411/1991ه) اعتقلت السلطات في النجف المرجع الديني آية اللّه العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي البالغ من العمر (95 عاماً) ومائة وخمسة (105) من عائلته ومريديه.
وفي كانون الثاني - يناير - من العام نفسه حاول المقرر الخاص مرة اخرى الضغط على الحكومة العراقية للحصول على معلومات عن المعتقلين وسلم شخصاً إلى نائب رئيس الوزراء طارق عزيز قائمة حديثة لمئة وخمسة (105) من المختفين من مريدي اية اللّه العظمى - التي قالت عنهم مؤسسة الخوئي انهم اعتقلوا واختفوا منذ اندلاع الانتفاضة - ولم يتسلم المقرر الخاص أي جواب من الحكومة العراقية بعد مضي خمسة اشهر.
لقد كان الشهيد السيد محمد تقي الخوئي قد وصف الوضع العام في النجف الأشرف والعراق حينذاك في رسالة خاصة بعثها إلى أخيه الشهيد السيد عبد المجيد الخوئي في لندن بعد عودته وسماحة والده المرجع الاعلى السيد الخوئي (قدّس سِرُّه) إلى النجف الأشرف من معتقلهما الذي قضيا فيه ثلاثة أيام في بغداد فقال السيد محمد تقي الخوئي : الوضع العام سيء، ويسير إلى الأسوأ، (مدرسة دار الحكمة) نسفت، و(مدرسة القزويني) حرقت، و(مدرسة المهدي) أصبحت مقراً للجمعية الاشتراكية، و(مكتبنا
ص: 627
في دار الحكمة) و (مكتبة السيد الحكيم) نهبتا تماماً بما في ذلك المخطوطات القيمة، وكذا الحال في بقية المدارس الدينية، حيث لم يبقى فيها سوى الطابوق، وهناك إشاعات عن نية الحكومة هدم الصحن الشريف في النجف الأشرف وكربلاء، وانشاء سياج حديدي بدلاً عنه على غرار مرقد الإمام الأعظم في بغداد، ويقال إن (مدرسة سامراء) سويت بالأرض.
ويستمر السيد محمد تقي الخوئي واصفا في رسالته سوء الحال الذي عانته مدينة النجف الأشرف العلمية المقدسة قائلاً : معظم أساتذة الحوزة العلمية وشخصياتها معتقلون، وأغلب الحسينيات بما فيها حسينية سماحة السيد (الخوئي) نسفت، كما قاموا بنهب بيتي في كربلاء تماماً.
ويقدر عدد معتقلي الجنوب والفرات بمائة وخمسين الفاً بينهم حوالي خمسة عشر ألفاً تقريباً من النجف الأشرف فقط جميعهم في مقر الأمن القومي ببغداد (منطقة الرضوانية).
الدبابات موجودة حول الصحن الشريف، والدخول إليه ممنوع، واكثر مقابر وادي السلام قد سويت بالأرض. الدفن هناك ممنوع، وتستخدم الحكومة الديناميت لهدم القبور، ولعل الحال في كربلاء من هذه الناحية أشد من النجف الأشرف.
وأضاف السيد محمد تقي الخوئي قائلا : نشرت مجلة (ألف باء) تفصيل القرار بهدم الصحن الشريف، ويبدو أن المشروع في طريقه إلى التنفيذ.
ويصف الشهيد السيد محمد تقي لأخيه في رسالة قصيرة لاحقة - يبدو أنها كتبت قبل محرم الحرام (1413 ه/ 1993 م ) بقليل - ما آل إليه الوضع المرعب قائلاً : قبل يومين زار المحافظ ومدير الأمن سماحة السيد (المرجع الأعلى السيد الخوئي) وطلبا منه
ص: 628
استقبال هيئة صحافية وتلفزيونية لإجراء مقابلة حية معه بمناسبة رأس السنة الجديدة والوضع العام، وكنت بخدمة سماحته فرفضنا ذلك باعتبار ان الوضع العام غير مساعد، لاسيما مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه المجالس الحسينية، وانتهى المجلس إلى مشادة عنيفة نسبياً بيني وبين الأمن، ثم انفضَّ المجلس. لكنه في اليوم التالي - أي يوم أمس - استدعى الأمن الشيخ شريف (القرشي) وابلغه في ضمن حديث طويل أن (جريدة القادسية) الناطقة باسم وزارة الدفاع قد هاجمتني في ضمن مقال لها عن الأوضاع في الجنوب بأني تحديداً بالاسم وراء كثير من الأمور التي جرت، وأنني شخصياً كنت المسؤول عن محاكمة المسؤولين وإعدامهم، وقد أرسلت لتحصيل الجريدة الا أنني لم أحصل عليها إلى هذه الساعة، ولا أدري هل أن كلام المدير (الأمن) يعني شيئاً وراء الستار، وإذا صح نشر الجريدة المقال المزعوم فاعتقد أنه لابد من الاستعداد للبلاء، ولا أدري هل بامكانكم فعل شئ أم لا. والأمر للّه وحده.
يقول الشهيد السيد محمد تقي الخوئي في رسالته السرية الخاصة الى أخية السيد عبد المجيد أيضا عارضاً ما قررته الدوله تجاه مراسم عاشوراء لتلك السنة، وما قامت به تجاه بعض المدارس الدينية ما نصه : منعت الحكومة هذه السنة إقامة المجالس نهائياً -حتى مجالس النساء - واعتقلت بعض أهل العلم لإقامتهم مجلساً صغيراً وخاصاً بهم في بيتهم، وفي مقابل ذلك أعلنت (جريدة الجمهورية) في عددها (7937 ليوم الاثنين 22 تموز - يوليو - 1991/ 1411ه) عن اقامة (أمسية غنائية في كربلاء في قاعة مركز شباب كربلاء، والدعوة عامة للجميع في يوم 24 تموز) ومن الجدير بالذكر أنه يصادف يوم دفن الامام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) الثالث عشر من محرم الحرام.
ص: 629
كما أقدمت السلطات على غلق مداخل كربلاء يومي تاسوعاء وعاشوراء، وردت السيارات التي اتجهت إلى كربلاء.
أما بالنسبة إلى الحسينيات فعمليات الهدم مستمرة، بخاصة في كربلاء حيث لم تبق حسينية واحدة بما فيها (مدرسة السيد البروجردي)، والحسينية التي لا يمكن تفجيرها تحال إلى المزاد العلني لبيع الانقاض، وهذه حالة جارية بالنسبة لبعض حسينيات بغداد أيضاً.
أما سامراء فقد سوي الموجود بالأرض (من رسالة خاصة للشهيد السيد محمد تقي الخوئي الى أخيه الشهيد لاحقا السيد عبد المجيد الخوئي).
وكذلك حال بقية الحسينيات والمساجد الكبيرة والمدارس الدينية بل حتى فروع مكتبات الإمام الحكيم العامة في أنجاء العراق وغير ذلك كثير.
تحدث المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة (ماكس فان دير شتويل) في أحد تقاريره الخاصة عن الانتهاكات التي تمس الشيعة في العراق بعد انتفاضة شعبان (1411ه/ آذار - مارس - (1991م) فيقول : لا يزال المقرر الخاص يتلقى معلومات تشير إلى استمرار الحكومة العراقية بتطبيق السياسات التمييزية والقمعية بصفة منتظمة على هذا المذهب الإسلامي، لاسيما على أعضاء ومنشآت مؤسسته الدينية، بل إن التدابير القمعية ضد الإثنية لطائفة الشيعة مثل الأكراد الفيلين
ص: 630
وعرب الأهوار والتركمان الشيعة كانت أشد ضراوة في أحيان كثيرة.
وفيما يتعلق بالممتلكات المادية لطائفة الشيعة أشار المقرر الخاص من قبل في تقاريره السابقة إلى تدنيس لوكالات حكومية مختلفة ومراكز للشرطة ودوائر الأمن، بل إنها استعملت أحياناً كمراكز احتجاز.
ويضيف شتويل: والواقع انه لم يصرح إطلاقاً بإعادة فتح المعهد الديني الوحيد في مدينة النجف المقدسة وهو كلية الفقه كأكاديمة أو مركز للتعليم منذ انتفاضة (آذار - مارس - 1991م / 1411ه). ويقال ان قاعات الدرس فيها تستعمل كحوانيت ومخازن تجارية للوازم مدرسية.
ويقال إن مؤسسات أخرى للتعليم العالي تعاني من قيود على مناهجها التعليمية.
ويقال في الوقت نفسه إن الحكومة تنقل سندات ملكية وإدارة حسينيات مختلفة (تبلغ وفقاً للتقارير الآف عدة في جميع ارجاء العراق) وممتلكات أخرى للشيعة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تقوم عندئذ بتغير أسمائها ووظائفها المحددة وهويتها الأساسية، وقد استمر ورود تقاریر بشان تدمير ممتلكات الشيعة منذ انتفاضة (آذار - مارس - 1991م/ 1411ه) أو في أعقابها.
ويستمر (ماكس فان دير شتويل) في تقريره الذي ورد ضمن كلمته في مجلس الأمن الدولي في (1411/1991/8/11ه) شارحاً الانتهاكات الفظيعة التي مارستها السلطات ضد الشيعة وعلمائها ومراجعهم فيقول : يجب عليّ أن أعبر عن قلقي العميق حول معاملة رجال الدين الشيعة بعد الانتفاضة في الجنوب في ربيع العام الماضي.
ان كثيراً منهم معتقلون، وقد بذلت جهوداً للحصول على معلومات عن مصيرهم من الحكومة العراقية من دون جدوى.
ص: 631
إن معاملة الحكومة العراقية للمعتقل الشيعي ظهرت بوضوح بعد وفاة أبو القاسم الخوئي، حيث منعت الحكومة مقلدية من المشاركه في تشيعه ومراسم الدفن، حيث من المتعارف أن الآفاً من الشيعة يشاركون في تشيع جثمان زعيمهم الديني، ولم تسمح سوى الستة مساعدين وشخص واحد من الأسرة بحضور مراسم الدفن التي أجريت فجراً (المصدر المتقدم آنفا).
وفي قضية مشابهة اعقبتها في حوالي سنة مارست الحكومة الدور نفسه أيضاً، فقد قامت كما يقول المقرر الأممي عند وفاة آية اللّه العظمى عبد الاعلى السبزواري في (آب - اغسطس - 1993م / 1413 ه- ) بمنع الموكب الجنائزي التقليدي أو قراءة الفاتحة على روحه علناً في العراق، فيما عدا الفاتحة في دائرة محدودة جداً في النجف.
وأمرت الحكومة بدفن آية اللّه العظمى فوراً، فدفن على عجل وبغير مراسم.
ان الطبيعة الغادرة لهذا الحظر بالتحديد تكمن في منع الاتصال الفعلي بين الزعامة الدينية والشعب على حساب تنمية المجتمع ناهيك عن فرض بقائه.
وفيما يتعلق بالمرجع وعلماء الحوزة العلمية الذين آثروا البقاء في النجف الأشرف على شدة الحال وخطورة الوضع، فقد ورد في تقرير المقرر الدولي الخاص بشأنهم قوله: لا تزال التقارير ترد عن مضايقتهم والتدخل في شؤونهم (..) وأن الحكومة قامت بالقوة بإغلاق المدخل الرئيسي لمسجد الخضراء في النجف الذي يؤدي فيه آية اللّه العظمى السيستاني الصلاة، وبذلك منعت وصول الجماهير إليه أثناء تأديته لأحدى أهم الشعائر الدينية.(1)
ويضيف المقرر الدولي الخاص بحقوق الإنسان قائلاً : وبينما استمر تدخل
ص: 632
الحكومة وفقاً للادعاءات في المؤسسات المادية والاجتماعية الأساسية لبنية الطائفة الدينية والمحافظة عليها فإن تدخلها استمر أيضاً انتهاكاً للمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الممارسات الجوهرية لمعتقدات الشيعة وشعائرهم. وتحديداً تفيد التقارير بأن حرية العبادة كتأدية الصلاة أصبحت جريمة من الجرائم، واضطر آلاف الأتباع لتأدية الصلاة في مجموعات صغيرة، وبشكل سري خوفاً من اكتشاف أمرهم.
وفي السياق نفسه منع مرة أخرى في السنة الماضية الاحتفال العام بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ)، كما منع تقليد إعداد الطعام وتوزيعه خلال شهر محرم الحرام، وبالمثل منع تشكيل المجالس للاحتفال بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كربلاء (هذه اللقاءات) تتم في جميع أرجاء العراق منذ قرون عدة للاستماع إلى رواية بسيطة السيرة الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ).
ويقال إنه فرض الحظر (سراً وعلانية) على تجمعات مجالس تقليدية أخرى للاحتفال بذكرى وفيات أئمة آخرين مثل مجلس الإمام الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) في حي الكاظمية في بغداد.
ويضيف المبعوث الأممي : ويقال أيضاً إن الوصول إلى مجموعات مهمة من كتب الشيعة الموجودة في المكتبات والجامعات (مثل المكتبة الوطنية، ومكتبة الأكاديمية العراقية، ومكتبة الأوقاف في بغداد) أصبح ممنوعاً وذلك بسحب الكتب الشيعية التقليدية من التداول أو بفرض حظر دائم عليها.
ص: 633
كذلك تفيد التقارير التي وردت إلى المقرر الخاص بأن أكثر من ألف من الكتب الدينية تعتبر غير مشروعة في العراق.
بيد ان أكثر أشكال التدخل تطفلاً وإساءة وغدراً هو الحضر الذي فرضته الحكومة وفقاً للتقارير على نشر وتوزيع تفسير اللّه العظمى السيستاني لرسالة الأحكام العملية (الدليل العملي لتأدية الشعائر اليومية والموسمية مثل الصلاة والصيام والوضوء وما إلى ذلك من الذي يحتوي على الفتاوى الدينية لآية اللّه العظمى) الذي يعتبر الكتاب والمرجع الرئيس لأتباعه.
لقد منعت الرسائل العملية للمراجع من الطباعة والبيع والشراء والتداول وبات رجال الأمن والمخابرات يداهمون باعة الكتب للتحري عن مثل كتاب (منهاج الصالحين) للمرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه)، وكتاب (الفتاوى الميسرة) لعبد الهادي الحكيم وفق فتاوى سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) وكتاب (المسائل الميسرة) لعبد الهادي الحكيم وفق فتاوى المرجع الأعلى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (دام ظلّه)، بل باتوا يصادرون الكتب ويعتقلون من وجدت عنده، وقد حدثني بعض باعة الكتب آنذاك أن رجال الأمن كانوا يداهمون مكتباتهم في أوقات غير محددة للتأكد من عدم وجودها هذه الكتب عندهم، وكيف كانوا يطبعونها سرا على آلات طباعة يدوية بدائية ويتداولونها كما لو كانت من المحرمات.
يقول الأستاذ حامد المؤمن(1) أحد المحققين والمتابعين للشأن الثقافي في العراق متحدثا عن معاناة الكاتب والكتاب في النجف الأشرف زمن النظام البائد بقوله: أصبح الكتاب (مصدر الوعي والثقافة والتنوير) العدو الاول للبعث الظلامي فبدأ يلاحقه، ويلاحق عاشقيه بكل وسيلة، بالمصادرة والاعتقال والإعدام. ولا أنسى كلمة تفوه بها مدير أمن النجف حين أجتمع بأصحاب المكتبات قائلاً لهم أدخلوا قنبلة ولا
ص: 634
تتدخلوا كتاباً، لأن القنبلة تقتل عشرة والكتاب يقتل ألفاً.
ولا أنسى كذلك صديقي المهذب (أبو حيدر) صاحب مكتبة الغدير في النجف الأشرف الذي عثر في محله على كتاب (مفاتيح الجنان) وهو كتاب أدعية مأثورة عن أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)چ فاعتقل وعذب حتى الموت.
ولا أنسى العشرات من المعارف والأصدقاء ممن كانوا يعشقون الكتاب - والنجف زاخر بهؤلاء - اضطروا أن يتلفوا كتبهم حرقاً أو دفناً في الأرض أو إلقاء في ماء النهر تخلصاً مما يجلب عليهم وجودها من متاعب واخطار وعقوبات تصل حد الإعدام.
ولا أنسى رؤيتي عند مروري قرب الفرقة الحزبية الملاصقة لمركز الإطفاء في النجف الأشرف (منظر الكتب المصادرة) ومنها المخطوط والمطبوع طبعة حجرية نادرة تطوح بها الرياح العاتية وتبليها الأمطار المتساقطة وهي مبعثرة على السطح المكشوف لهذه الفرقة الحزبية، ولا تتصور كم من الألم اعتصر فؤادي لهذا المنظر وأنا أرى عصارة أفكار النوابغ والعباقرة الذين مروا عبر التاريخ وغذوا أجيالاً وبنوا عقولاً وهي تهان بهذه الطريقة وتباد بهذا الاسلوب، إنه البعث وما أظلمه وأجهله «يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّه بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّه إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ»
ولقد تعرضتُ أنا لمثل هذه التجربة فقد عثر في مكتبي، في واحدة من حملات الدهم والتفتيش على كتاب ( هوية التشيع) من تأليف عميد الخطباء الشيخ أحمد الوائلي وقد كان كتاباً مستنسخاً لندرة الكتب في هذا الباب الممنوعيتها، فاعتقلتُ أسابيع وحقق معي تحقيقاً رهيباً وقدمت للمحكمة.
وفي فترة من تلك الفترات المظلمة حيث كان الكتاب الشيعي والإسلامي مفقوداً الأسواق وممنوعاً من التداول، والناس متعطشون إلى اقتنائه وقراءته والإفادة منه
ص: 635
والتزود من علوم أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ)، رأيت من (الواجب الشرعي) القيام بنقل الكتاب الشيعي من شمال العراق (السليمانية بالذات) إلى وسط وجنوب العراق، مع ما يحف بهذا الأمر من الصعوبات والمخاطر، ولكني لم أكترث بكل ذلك مستبصراً برحمة اللّه وحفظه وبركة علوم أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).
فأدخلت الكتب بآلاف العناوين، وبمئات الآلاف من النسخ مستعيناً بذلك ببعض الإخوة من الأكراد - الذين نال بعضهم شرف الشهادة على أيدي جلادي البعث وجلاوزته - فحرصت على أن يدخل الكتاب كل بيت عراقي، فأصبحت هذه الكتاب تباع على أرصفة شوارع المدن العراقية.
وحرصت أكثر على توفير الكتب ( الدراسية) لطلبة الحوزات العلمية بين سنتي (1997م – 2002م) وكان ذلك مصدر حيرة وقلق لرجال الأمن والمخابرات لنظام البعث الإرهابي الذي عجز تماماً عن معرفة مصدر دخول هذه الكتب وأسلوب وصولها، مما أشعره بعجزه تماماً عن وقف السيل الجارف للفكر الإسلامي الأصيل.
ويرى المقرر الخاص ان التدخل في مثل هذه المؤلفات البسيطة، وان تكن مهمة، لا يشكل فقط انتهاكاً للمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنة يشكل أيضاً انتهاكاً للمادة (19) المتعلقة بحرية المعلومات.
ص: 636
1 - ينظر : عبد الهادي الحكيم. مجلة النور. لندن. العدد 161. رمضان 1425ه / تشرين الثاني 2004م. ص: 62 وما بعدها.
2 - ينظر : د. صاحب الحكيم : تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق، أس سي أس / 23685 رقم 1 في 9 آذار مارس 1992م : ص 36.
3- ينظر: عبد الهادي الحكيم : محنة أسرة علمية عراقية آل الحكيم أنموذجا. مخطوط
4 - ينظر : د. صاحب الحكيم : تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق، أس سي أس / 23685 رقم 1 في 9 آذار مارس 1992 م.
5- من شهادة خاصة عن حال الكتب والمكتبات زمن النظام البائد أجاب بها الأستاذ المؤمن مؤلف الكتاب إثر سؤاله عن شهادته الحسية ذلك الوقت.
ص: 637
إحصائية أولية ب(أساتذة البحث الخارج من غير المراجع)، و (أساتذة السطوح العالية : المكاسب والرسائل والكفاية ) في حوزة النجف الأشرف لسنة 1433ه/ 2012 م).
يحسن بي أن أقول باديء ذي بدء بأني لا أزعم بحال بأن إحصائيتي هذه هي إحصائية تامة، وهو ما دعاني الى عنونتها بعنوان (الأولية) ذلك أن الإحصاء الدقيق لأساتذة البحث الخارج والسطوح العالية في حوزة النجف الأشرف ليست باليسيرة، لأسباب منها أفتقار مؤسسة الحوزة الى سجل خاص بهم، وعدم وجود إحصاء سابق لهم، سوى ما أثبته في الطبعة الأولى من كتابي هذا، رغم اكتشافي لاحقا عدم شموله لبعضهم سهوا، ومنها أن الأستاذ قد يدرِّس في بيته أو في مسجد غير مشهور، مما يزيد من صعوبة الاطلاع على موضوع درسه أو مستواه، ومنها انتقال بعض الأساتذة من تدريس السطوح الأولية الى تدريس السطوح العالية حديثا أو نحو ذلك، مما قد يحتاج الى فترة ما لمعرفة ذلك التوسع العلمي في مادة تدريسه ومنها انتسابه حديثا الى حوزة النجف الأشرف بعد هجرته اليها من حوزات أخرى داخل العراق أو خارجه، ومنها تحول الأستاذ المدرس للسطح الأولي خلال تدريسه لمتن كتابه نفسه من مستوى السطح الأولي مستوى السطح العالي بحيث قد تعد توسعته تلك انتقالة منه الى مستوى السطح العالي. ومنها، ومنها... إلخ.
بيد أني سعيت جهدي فسألت بعض أفاضل الأساتذة المرموقين فساعدني على
ص: 638
إعداد قائمة أولية بأسمائهم حسب معرفته، ثم حملتها لأطوف بها على هذا الأستاذ أو ذاك، وهذا المكتب المرجعي أو ذاك، ممن أثق بدقة تشخيصهم للمستويات العلمية مع تحرجهم من إضافة من لا ينطبق عليه هذا الوصف اليها، فأشاروا عليّ بما اعتقدوه، فزدت، وهكذا كنت أراوح بين تشخيص هذا، وإشكال ذاك، الى حيث السؤال مجددا، ثم السؤال، ثم الحذف أو الإضافة حتى استقرت بي الإحصائية على ما استقرت عليه، فيما يأتي، فإن كنت أصبت في تشخيص الأساتذة المستحقين فعلا لنيل هذه المرتبة المتقدمة، في هذه الحوزة العلمية العريقة، ووفقت لعدم السهو فيه، فبعون اللّه ما كان، وإن تكن الأخرى، فحسبي أنني حاولت، مع الاعتذار سلفا عن الغفلة والنسيان، والله من وراء القصد، وهو حسبي ونعم الوكيل.
وفيما يأتي قائمة بأسماء (أساتذة البحث الخارج من غير المراجع) وأساتذة السطوح العالية (المكاسب والرسائل والكفاية) في حوزة النجف الأشرف الحالية خلال عام (1433 ه/ 2012 م) حسب تسلسل الحروف الهجائية.
ت النسب الاسم واللقب
1السيد احمد الاشكوري
2الشيخ احمد البهادلي.
3السيد احمد السيد محمد صالح الخرسان
4الشيخ احمد شهاب الشمري
5السيد احمد الصافي
6الشيخ أحمد العوادي
7 الشيخ سعد الفهداوي
ص: 639
9السيد آصف الموسوي
10الشيخ امجد رياض السعدي
11الشيخ أمجد البغدادي
12الشيخ امين المامقاني
13الشيخ باقر الايرواني
14الشيخ باقر القرشي
15الشيخ بشار أبو كلل
16السيد جعفر السيد عبد الصاحب الحكيم
17الشيخ جاسم الفهدي
18السيد جعفر المروج
19الشيخ جليل حميد الطائي
20السيد جواد الغريفي
21الشيخ حسن الصالحي
22السيد حسن المرعشي
23السيد حسين السيد عبد الصاحب الحكيم
24السيد حسين السيد علاء الدين الحکیم
25السيد حسين الكربلائي
26الشيخ حسين خضر الظالم
27الشيخ حيدر ضياء جعفر الجهلاوي
28السيد حيدر المؤمن
29الشيخ حيدر ناصر علي الوكيل
30الشيخ خالد السويعدي
ص: 640
31الشيخ رافد الحاوي
32الشيخ رافد الفتال
33الشيخ رجب على المحمدي
34السيد رشید الحسینی
35السید رضي المرعشي
36الشيخ ستار الجيزاني
37الشيخ سعد الفهداوي
38الشيخ شهاب الدین احمد
39الشيخ صادق الساعدي
40السيد صادق الموسوي
41الشيخ صادق الناصري
42السيد صالح الخرسان
43الشيخ ضياء زين الدين
44السيد طعمة الجابري
45السيد عادل السيد عبد الزهرة الحكيم
46الشيخ عباس السراج
47الشيخ عباس العوادي
48الشيخ عبد الجبار الخزاعي
49السيد عبد الحسين القاضي
50الشيخ عبد الرضا الرويمي
51الشيخ عبد الرضا الهندي
52السيد عز الدين السيد محمد سعيد الحكيم
ص: 641
54السيد علاء الدين السيد محمد سعيد الحكيم
55السيد علاء الموسوي الهندي
56السيد علي اكبر الحائري
57الشيخ علي الجواهري
58الشيخ علي الربيعي
59السيد على السيد محمد حسين الحكيم
60الشيخ علي ايوب الربيعي
61الشيخ علي السوبعدي
62السيد علي السيد محمد صادق الحكيم
63الشيخ علي القاينى
64الشيخ علي ضياء الجواهري
65الشيخ علي عبد اللّه حسون الوائلي
66السيد على الهاشمي
67الشيخ علي البهادلي
68الشيخ علي الساعدي
69الشيخ عمار الخزعلي
70الشيخ غالب الناصر
71الشيخ غزوان جميل الخزاعي
72السيد غسان الخرسان
73الشيخ فرقد الجواهري
74الشيخ قاسم داود
75الشيخ قاسم اللامي
ص: 642
76الشيخ الكلباسي
77الشيخ كريم الربيعي
78الشيخ کریم میسر
79الشيخ مجيد الصائغ
80الشيخ محراب علي الرحيمي
81الشيخ محمد البغدادي
82السيد محمد البكاء
83الشيخ محمد البهادلي
84الشيخ محمد جبير الكعبي
85السيد محمد الحسني
86الشيخ محمد السند
87الشيخ محمد السعودي
88الشيخ محمد الفرطوسي
89السيد محمد القاضی
90الشيخ محمد الماجدي
91الشيخ محمد عبد الحسين حسين آل حيدر
92السيد محمد باقر السيد محمد صادق الحكيم
93السيد محمد باقر السيستاني
94السيد محمد باقر العلوي
95السيد محمد جعفر السيد محمد صادق الحكيم
96الشيخ محمد جواد المهدوي
97السيد محمد حسين السيد محمد صادق
ص: 643
98السيد محمد حسين السيد محمد سعيد الحكيم
99الشيخ محمد حیدر
100السيد محمد رضا الخرسان
101السيد محمد رضا السيستاني
102السید محمدرضا الغريفي
103 الشيخ محمدرضا الفياض
104 الشيخ محمد رضا حرز الدين
105السيد محمد مكي زبيبة
106السيد محمد صادق الخرسان
107السيد محمد صالح الحكيم
108السيد محمد طاهر الجزائري
109 الشيخ محمد طاهر الخاقاني
110 الشيخ محمد علي الأفغاني
111 الشيخ محمد على الرحيمي
112السيد محمد على بحر العلوم
113الشيخ محمد مهدي الأصفي
114السيد محمد هادي الشيرازي
115 الشيخ محمد الكعبي
116 السيد مقداد السيد محمد صالح الحكيم
117 الشيخ منذر جميل الخزاعي
118 السید مهدي الخرسان
119 الشيخ موفق الجنوبي
ص: 644
120 الشيخ ميثم الخنيزي
121 السيد ميثم السيد عبد الرزاق الحكيم
122 السيد نصر الدين الكاظمي
123 الشيخ نصير السعدي
124 الشيخ نجاح العبودي
ص: 645
صورة الدراسة في (حسينية المدرسة الغروية) الملحقة بالصحن العلوي الشريف ويلاحظ سماحة الشيخ محمد هادي آل راضي يلقي بحثه في مرحلة البحث الخارج على طلابه سنة 1433ه/ 2012م. (صورة خاصة)
الصورة

ص: 646
صورة الدراسة في إحدى غرف الصحن العلوي التي ضمت أجداث كبار علماء حوزة النجف الأشرف، ويشاهد سماحة السيد محمد صادق الخرسان يلقي بحثه على طلابه في مرحلة السطوح العليا سنة 1433ه/ 2012م ( صورة خاصة)
الصورة

ص: 647
صورة الدراسة في مسجد عمران بن شاهين في النجف الأشرف، ويشاهد سماحة الشيخ محمد سند يلقي بحثه على مستوى البحث الخارج على طلبته أواسط سنة 1433 ه/ 2012م ( صورة خاصة)
الصورة

ص: 648
صورة الدراسة في جامع الخضراء ومقبرة السيد الخوئي (قدّس سِرُّه)، ويشاهد سماحة السيد علاء الموسوي الهندي يلقي بحثه على مستوى السطوح العليا (عام 1433 ه/ 2012م). ( صورة خاصة)
الصورة

ص: 649
صورة الدراسة في جامع الشيخ الطوسي في النجف الأشرف، ويشاهد سماحة السيد جعفر السيد عبد الصاحب الحكيم يلقي بحثه على طلابه في مرحلة السطوح العليا سنة 1433ه/ 2012م. (صورة خاصة)
الصورة

ص: 650
صورة الدراسة في مكتبة العلمين الملحقة بجامع الشيخ الطوسي ويشاهد في الصورة سماحة السيد محمد علي بحر العلوم يلقي بحثه على طلابه سنة 1433 ه/ 2012م. (صورة خاصة )
الصورة

ص: 651
صورة الدراسة في جامع الجواهري ويشاهد في الصورة سماحة الشيخ حسن الجواهري يلقي بحثه على طلابه في النجف الأشرف سنة 1433 ه/ 2012م. ( صورة خاصة)
الصورة

ص: 652
صور الدراسة في مرحلتي المقدمات والسطوح، وتشاهد حلقاتها في المسجد الهندي في النجف الأشرف سنة 1433 ه/ 2012 م. (صور خاصة)
الصورة

ص: 653
الصورة

ص: 654
صورة الدراسة في مقبرة علماء أسرة آل الحكيم المنفتحة أبوابها على باحة (المسجد الهندي) بالنجف الأشرف، ويشاهد سماحة السيد حسين الحكيم يلقي بحثه في (الكفاية) على طلابه أوائل (عام 1433 ه/ 2012م). ( صورة خاصة)
الصورة

ص: 655
صورة الدراسة في الحسينية الأعسمية، ويشاهد سماحة السيد أحمد الإشكوري يلقي بحثه على مستوى السطوح العليا (عام 1433 ه / 2012م). (صورة خاصة)
الصورة

ص: 656
صورة الدراسة في (حسينية آل محي الدين ) ويشاهد سماحة السيد رشيد الحسيني يلقي بحثه على مستوى السطوح العليا سنة 1433 ه/ 2012م. (صورة خاصة)
الصورة

ص: 657
صورة للدراسة في البيوت والمكاتب ويشاهد سماحة السيد أحمد الصافي يلقي بحثه على مستوى السطوح العليا سنة 1433 ه / 2012م. (صورة خاصة)
الصورة

ص: 658
صورة كتاب منح درجة الأستاذية الممنوحة لسماحة السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) أستاذا لأصول الفقه في معهد الدراسات الإسلامية العليا بجامعة بغداد سنة 1384 ه/ 1964م.
الصورة
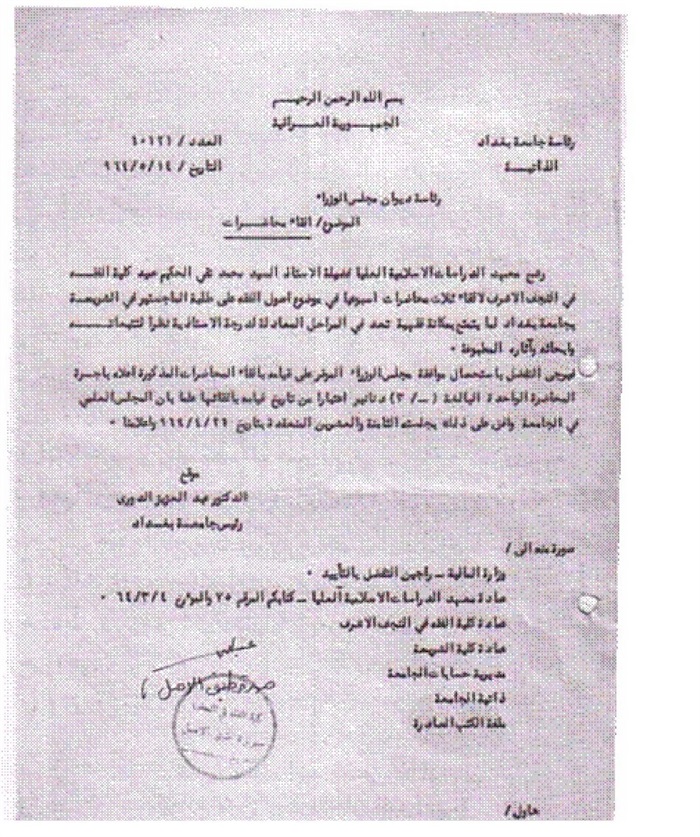
ص: 659
الملحق الخامس والعشرون
صورة كتاب انتخاب سماحة آية اللّه المجدد السيد محمد تقي الحكيم (قدّس سِرُّه) عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1387 ه/ 1967 م بتوقيع رئيس المجمع الدكتور طه حسين
الصورة
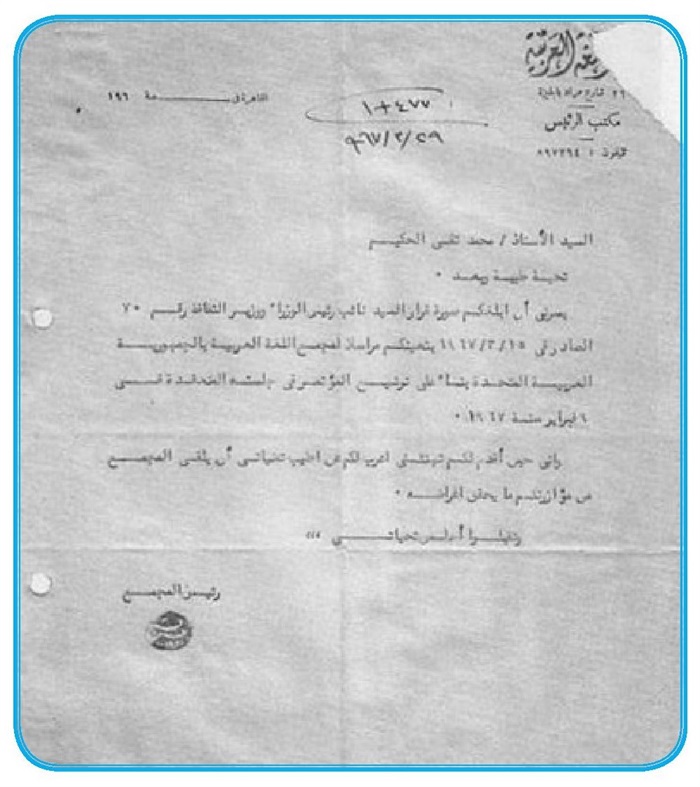
ص: 660
إحصائيات مستفادة من أعداد الطلبة المسجلين والمشاركين في امتحانات حوزة النجف الأشرف للسنوات الست الماضية
(1426 - 1431 ه / 2005 - 2010م)
أضع بين يدي القارئ الكريم بعض الإحصائيات المستفادة من أعداد الطلبة المسجلين والمشاركين للسنين الست الماضية المدرج في صلب البحث والذين يشكلون بمجموعهم قسما من طلبة حوزة النجف الأشرف الحالية، لا كلّهم، محاولا أن أقراها وأحلل بعض ما ورد فيها عسى أن تكون نتائجها نافعة لمتولي شؤون هذه الحوزة العلمية العريقة وغيرهم من المعنيين بشؤونها، معينة لهم على تخطيط ورسم استراتيجياتها في المراحل المقبلة إن شاء اللّه.
فيما يأتي أربع مخططات، وجدولان، يتبين من خلالها أعداد الطلبة المسجلين والمشاركين في الامتحانات، ونسب طلبة المقدمات والسطوح الى مجموع أعداد الطلبة المشاركين في الأمتحانات، مع مقارنة سنوية بين أعداد الطلبة المشاركين في امتحانات حوزة النجف الاشرف، مقسمة حسب علوم: الفقه وأصول الفقه، والنحو، والمنطق ، الى غير ذلك مما هو مدون مع كل مخطط أو جدول.
ص: 661
أعداد الطلبة المسجلين والمشاركين في امتحانات حوزة النجف الاشرف للسنوات من (1426-1431ه / 2005-2010 م)
الصورة
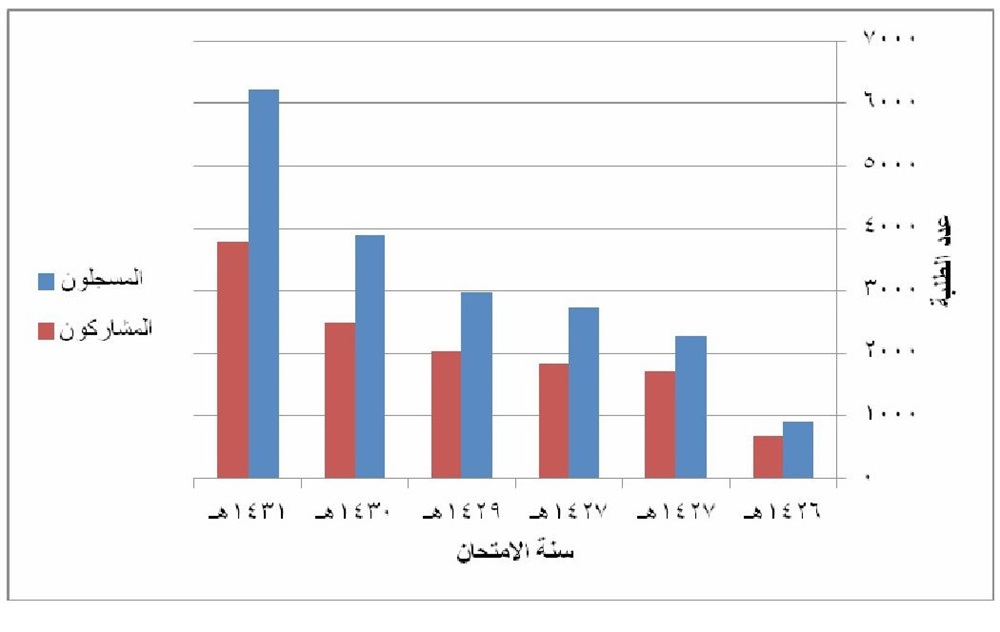
ص: 662
أعداد طلبة المقدمات والسطوح من مجموع المشاركين في امتحانات حوزة النجف الاشرف للسنوات من (1426 - 1431ه / 2005 - 2010 م )
الصورة
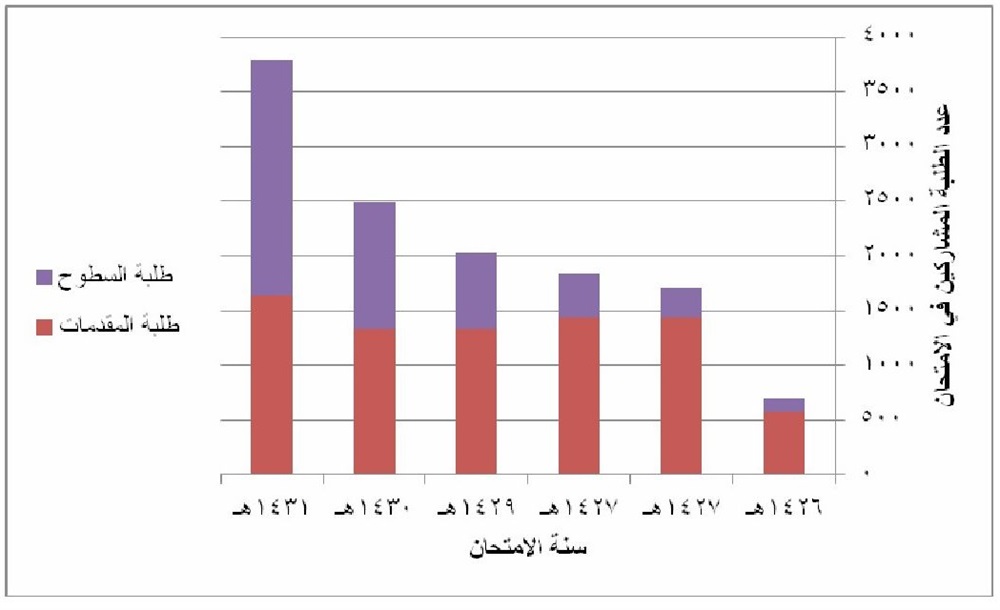
ص: 663
مقارنة سنوية بين أعداد الطلبة المشاركين في امتحانات حوزة النجف الاشرف مقسمة حسب علوم :الفقه، وأصول الفقه، والنحو، والمنطق للسنوات من (1426 - 1431ه/ 2005-2010 م)
الصورة
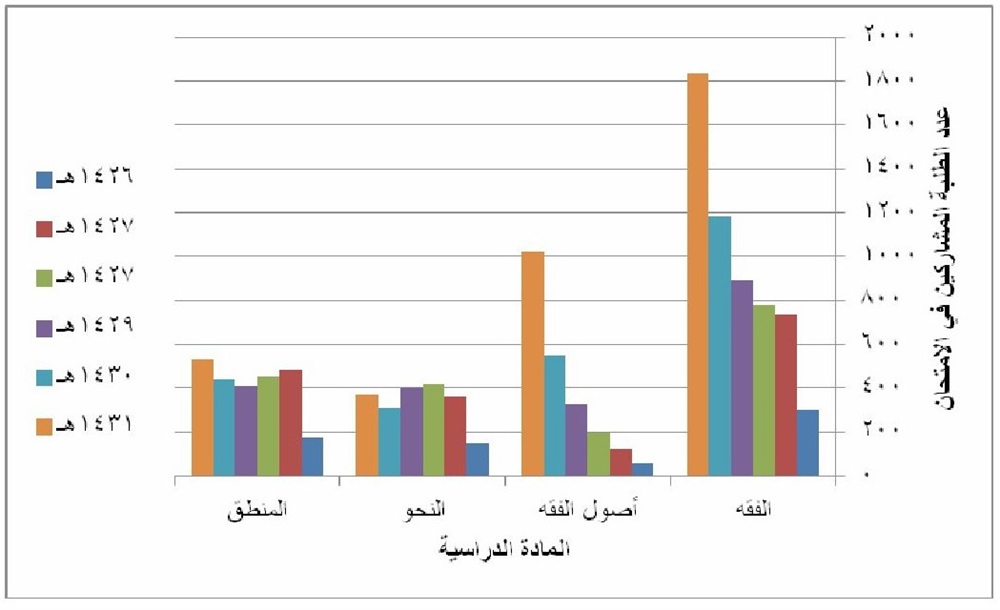
ص: 664
مقارنة بين أعداد طلبة علوم الفقه، وأصول الفقه، والنحو، والمنطق المشاركين في امتحانات حوزة النجف الأشرف للسنوات من (1426 - 1431 ه / 2005 - 2010 م)
الصورة

ص: 665
نسب طلبة المقدمات والسطوح من مجموع المسجلين والمشاركين في امتحانات حوزة النجف الاشرف للسنوات من (1426 - 1431ه / 2005 - 2010 م )
الصورة

ص: 666
توزيع الطلبة حسب علوم الفقه وأصول الفقه والمنطق والنحو من مجموع المسجلين والمشاركين في امتحانات حوزة النجف الأشرف للسنوات من (1426 - 1431ه/ 2005-2010 م)
الصورة

وتبدو من خلال قراءة نتائج الإحصائيات المتقدمة للسنوات الدراسية (1426 - 1431 ه/ 2005 - 2010م) النتائج التالية :
1 - التزايد المطرد باعداد الطلبة المسجلين والمشاركين في امتحانات حوزة النجف
ص: 667
الأشرف للسنوات من (1426 - 1431ه) (ينظر المخطط : رقم 1 ).
2 - إن الارتفاع بأعداد ونسب طلاب مرحلة السطوح يفوق تزايد طلاب مرحلة المقدمات بشكل ملحوظ، مما يشير لنمو نوعي وكمي واضحين في أعداد الطلبة ومستوياتهم العلمية. (ينظر مخطط رقم : 2: وجدول رقم : 1).
3- إنّ تفاوت نسب النمو في أعداد الطلبة بين مرحلتي المقدمات والسطوح يعود لأسباب عدة منها :
أ- مواصلة طلاب المقدمات الناجحين في السنين السابقة لدراسة مرحلة السطوح. (ينظر مخطط رقم : 2: وجدول رقم : 1)
ب- توافد الطلبة من خارج حوزة النجف الأشرف عليها بعد إكمالهم مرحلة المقدمات في مدنهم، سواء من كان منهم قادما محافظات العراق المختلفة، أم من دول أخرى، مما ينتج طبيعيا زيادة في أعداد طلبة مرحلة السطوح في حوزة النجف الأشرف مقارنة بطلبة مرحلة المقدمات فيها.
4 - يمكن تفسير زيادة المشاركين في امتحانات علمي الفقه وأصول الفقه مقارنة بعلمي النحو والمنطق بكون علمي الفقه وأصول الفقه يدرسان خلال مرحلتي المقدمات والسطوح معا، بخلاف علمي النحو والمنطق الذين يدرسان ضمن مرحلة المقدمات حصرا (ينظر جدول رقم : 2، ومخطط رقم : 3 و 4 ).
ص: 668
صورة لطلاب مدرسة الإمام الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) عام سنة 1432 ه / 2011م (صورة خاصة)
الصورة

ص: 669
صورة لطلاب مدرسة (دار الحكمة للبنين ) سنة 1432 ه/ 2011م ( صورة خاصة)
الصورة

ص: 670
الهيئة العلمية لمؤسسة شهيد المحراب نتائج استبيان العنف ضد المرأة
الصورة

ص: 671
مؤسسة زين الدين (قدّس سِرُّه) للمعارف الإسلامية
من برامج مؤسسة الشيخ زين الدين (قدّس سِرُّه) ويشاهد سماحة الشيخ ضياء الدين زين الدين يلقي محاضرته سنة 1432 ه/ 2011م ( صورة خاصة)
الصورة

ص: 672
الصورة
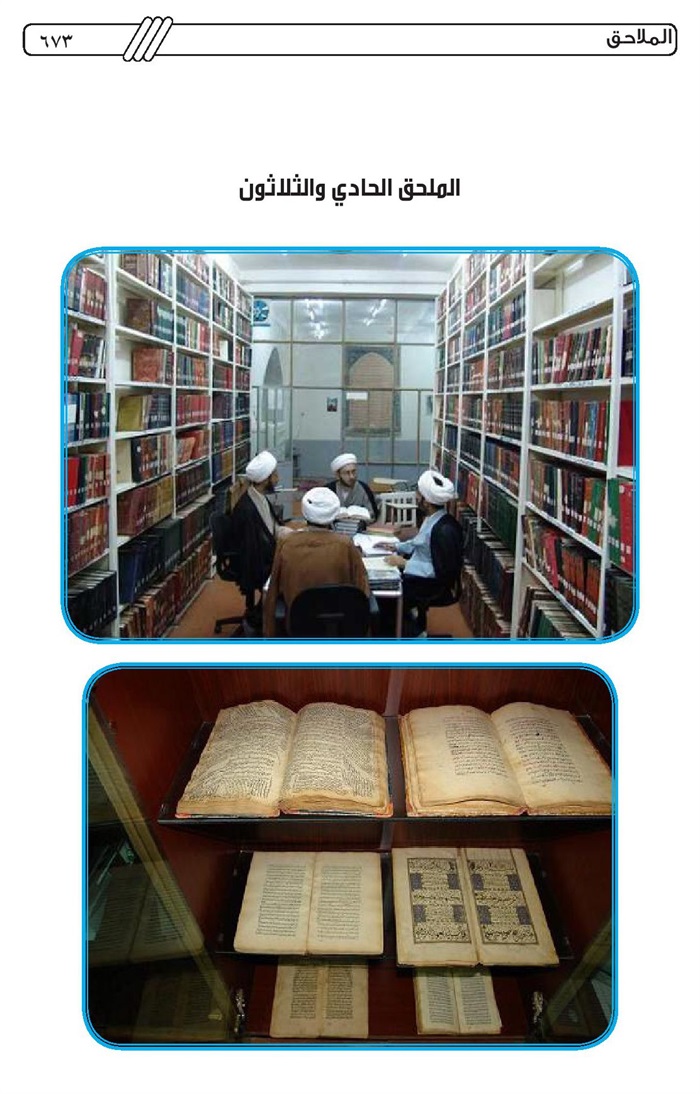
ص: 673
ص: 674
1- الأحلام. الشيخ علي الشرقي. موسوعة الشيخ علي الشرقي النثرية / القسم الرابع جمع وتحقيق موسى الكرباسي. مطبعة العمال المركزية. بغداد. جمهورية العراق. 1991م.
2 - أساطين المرجعية العليا في النجف. الدكتور محمد حسين الصغير. ط1. مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 2003م.
3- الأصول العامة للفقه المقارن. السيد محمد تقي الحكيم. ط4. المؤسسة الدولية للدراسات والنشر بيروت لبنان. 2001م.
4 - ابتكارات الأستاذ الإمام الميرزا النائيني (قدس سره) في علم الأصول. د. الشيخ محمد حسين الصغير. بحث ضمن بحوث : مدرسة النجف الأشرف ودورها في اثراء المعارف الإسلامية. كلية الفقه. النجف الأشرف. العراق 2006م.
5 - أعيان الشيعة. السيد محسن الأمين.ط. 5. دار التعارف للمطبوعات. بيروت. لبنان 1998م.
6 - آلية البحث عن الوظيفة العقلية في منظور السيد محمد تقي الحكيم. السيد محمد صادق السيد محمد رضا الخرسان. بحث ضمن بحوث كتاب (مدرسة النجف الأشرف ودورها في اثراء المعارف الإسلامية) كلية الفقه. جامعة الكوفة العراق 2006م.
ص: 675
7- تاريخ وتطور الفقه والأصول في حوزة النجف الأشرف العلمية. السيد محمد جعفر الحكيم. ط 3. المؤسسة الدولية للدراسات والنشر. بيروت. لبنان 1423.ه 2002م.
8- التشيع في ندوات القاهرة. السيد محمد تقي الحكيم. ط 1. مؤسسة الإمام علي ومركز الارتباط بسماحة آية اللّه العظمى السيد السيستاني (دام ظلّه). بيروت. لبنان. 1999م.
9 - حقائق التاويل في متشابه التنزيل. السيد الشريف الرضي. تقديم الشيخ محمد رضا المظفر. النجف الأشرف. العراق. 1355 ه.
10 - جامعة النجف الدينية. د. فاضل الجمالي. بحث. ترجمه عن الإنكليزية الدكتور جودت القزويني. مجلة الموسم. العدد 18 لسنة 994. العدد 18 لسنة 1994م. وكذلك مجلة شؤون إسلامية. العدد 2. السنة الثانية. ذو القعدة / ذو الحجة 1420ه شباط / آذار 2000م. لندن. المملكة المتحدة.
11 - جنة المأوى. الشيخ محمد الحسين ال كاشف الغطاء. تقديم السيد محمد علي القاضي الطباطبائي. ط2. دار الأضواء. بيروت. لبنان. 1408ه/ 1988م.
12 - حفلة وضع الحجر الأساسي لبناية كلية منتدى النشر في النجف الأشرف. النجف الأشرف جمهورية العراق. 1953م.
13 - حوار مع الشيخ باقر الإيرواني. مجلة فقه أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) قم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران.
14 - حوار مع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. مجلة فقه أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ). قم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران السنة التاسعة. 2004م.
ص: 676
15 - الحياة الفكرية في النجف الأشرف (1340 - 1364 ه / 1921 - 1945م) د. محمد باقر أحمد البهادلي. ط 1. المطبعة ستارة. الجمهورية الإسلامية في إيران. 1425ه- 2004م.
16 - دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. حسن الأمين. ط5. دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. 1418ه/ 1998م.
17- دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري. الشيخ باقر الإيرواني. ط 2. مؤسسة الفقه للطباعة والنشر. قم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران. 1420ه.
18 - دروس- تمهيدية في القواعد الرجالية. الشيخ باقر الإيرواني. ط1. المركز العالمي للعلوم الإسلامية. قم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران. 1417ه.
19 - دروس في أصول فقه الإمامية. الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي. ط 1. مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر. 1420ه.
20 - دروس في الفقه الاستدلالي من فقه العبادات. 1. كتاب الطهارة. الشيخ باقر الايرواني. مكتب تدوين المناهج الدراسية 33. المركز العالمي للدراسات الإسلامية. قم. الجمهورية الإسلامية في إيران. 1382ه هجري شمسي.
21 - الديوان. د. السيد مصطفى جمال الدين ط 1. دار المؤرخ العربي. بيروت. لبنان. 1415ه/ 1995م.
22 - رجال السيد بحر العلوم. السيد محمد صادق بحر العلوم. ط 1. مكتبة الصادق طهران الجمهورية الإسلامية في ايران. 1363 هجري شمسي.
ص: 677
23 - رحلتي الدراسية مع السيد التقي الحكيم الدكتور محمود المظفر. منشور ضمن : كتاب السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف. ط1. معهد الدراسات العربية والإسلامية. لندن المملكة المتحدة. 2003م.
24 - رحيل العلامة الحكيم الشيخ محسن الأراكي. مجلة البلاغ العدد 13. أيلول – سبتمبر. 2001 م. رجب - رمضان. 1422ه- لندن. المملكة المتحدة.
25 - رسالة الثقلين. مجلة المجمع العالمي لأهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) قم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران. السنة الثالثة 1415ه / 1994 م.
26 - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن. تحقيق وإخراج وتعليق عبد الحسين محمد علي. الطبعة المحققة الثانية. دار الأضواء. بيروت لبنان 1983م.
27 - الشيخ الأنصاري من خلال آراء الفقهاء والعظماء والمؤلفين. الشيخ محمد جواد الطبسي. ط 1. الأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. قم الجمهورية الإسلامية في ايران.1373ه.ش.
28 - الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف الأشرف. الشيخ محمد مهدي الآصفي. سلسلة رواد الإصلاح. الكتاب الثالث. ط1. مؤسسة التوحيد للنشر الثقافي. قم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في ايران. 1419 ه 1998م.
29 - شيعة العراق. إسحاق نقاش. الطبعة العربية الأولى. ترجمة عفيف الرزاز. مؤسسة الأبحاث العربية. بيروت لبنان.1992م.
30 - العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. تحقيق الدكتور جودت القزويني. ط 1. بيروت. لبنان.1998م.
ص: 678
31- العلامة الحكيم وحركة الاصلاح في الحوزة العلمية في النجف. السيد محمد باقر الحكيم. بحث منشور ضمن : كتاب السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف الأشرف. معهد الدراسات العربية والإسلامية لندن المملكة المتحدة 1424ه- 2003م.
32- علم الأصول نظرة جديدة في مناهه الدراسية في حوزة النجف. حوار مع المرجع السيد محمد سعيد الحكيم. مجلة التحقيق والحوزة. عدد خاص بحوزة النجف الأشرف السنة الرابعة مركز الدراسات والبحوث التابع لإدارة الحوزة في قم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران من دون ذكر سنة الطبع.
33- الغابة العذراء. دراسات في الشعر النجف الحديث. إعداد : حامد المؤمن. ط 1. بغداد العراق 1999م.
34- الفكر الإسلامي. مجلة مجمع الفكر الإسلامي. قم المقدسة الجمهورية الإسلامية في إيران. 1414ه.
35- فصول من تاريخ النجف وبحوث أخرى. ط 1. عبد الرحيم محمد علي. إعداد ومراجعة وإضافة وتوثيق. د. كامل سلمان الجبوري. 1432 ه / 2011م.
36 - الفكر الإمامي من النص حتى المرجعية. الدكتور الشيخ محمد حسين الصغير. ط1. دار المحجة البيضاء. بيروت. لبنان 2003م.
37- فقه أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ). مجلة فقهية تخصصية. مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ). قم الجمهورية الإسلامية في ايران. 1616ه / 1995م.
38- قانون منتدى النشر. جمعية منتدى النشر. ط 1. مطبعة الراعي في النجف.
ص: 679
النجف الأشرف. العراق. 1354ه.
39 - الكافي في أصول الفقه السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم. ط 2. قم. الجمهورية الإسلامية في ايران. 1422ه/ 2001م.
40 - كتاب المكاسب. الشيخ مرتضى الأنصاري. إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم. مجمع الفكر الإسلامي. قم. الجمهورية الإسلامية في إيران. 1417ه.
41 - كفاية الأصول الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخوند. تحقيق مؤسسة آل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ) لإحياء التراث. تقديم السيد جواد الشهرستاني. قم. الجمهورية الإسلامية في إيران. 1417ه.
42 - مؤسسة الدراسة الدينية الشيعية في النجف وكربلاء خلال القرن التاسع عشر من منظور غربي. مائير لدفاك أنموذجا. بحث تخرج. د. محمد عبد الهادي الحكيم. مخطوط. 1998م.
43 - مالك الأشتر حياته وجهاده. السيد محمد تقي الحكيم. ط 1. المؤسسة الدولية للدراسات والنشر. بيروت لبنان 1422ه / 2001م.
44 - محنة الأهوار والصمت العربي الدكتور السيد مصطفى جمال الدين. ط 1. لندن. المملكة المتحدة. 1993.
45 - المدارس القديمة والحديثة في النجف. الشيخ محمد الخليلي. ط 1. النجف الأشرف. العراق.
46 - المرجعية الدينية / 2. في حوار صريح مع المرجع السيد محمد سعيد الحكيم.د عبد الهادي الحكيم. ط 3. مؤسسة المرشد. بيروت لبنان. 2001م.
ص: 680
47 - مع علماء النجف الأشرف السيد محمد الغروي. ط 1. دار الثقلين. بيروت. لبنان. 1999م.
48- معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام. د. الشيخ محمد هادي الأميني. ط 2. من دون ذكر مكان الطبع. 1413ه 1992م.
49 - مقالات الأصول الشيخ ضياء الدين العراقي. ط1. تحقيق الشيخ محسن العراقي والسيد منذر الحكيم المكتبة الأصولية.6 مجمع الفكر الإسلامي12. قم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران. 1414ه.
50 - مقدمات كتب تراثية. السيد محمد مهدي الخرسان. ط 1. مكتبة الروضة الحيدرية / 6. النجف الأشرف. العراق 1427ه.
1 5 - مقدمة كتاب مالك الأشتر للسيد محمد تقي الحكيم. بقلم الشيخ محمد رضا المظفر. الطبعة 2. المؤسسة الدولية للدراسات والنشر. بيروت لبنان 2001م.
52 - ملاحق أعيان الشيعة. السيد محسن الأمين. دار التعارف للمطبوعات. بيروت لبنان. 1993م.
53 - المنتدى تاريخ وتطور. أضواء على الفكرة السيد محمد تقي الحكيم. مجلة النجف. النجف الأشرف جمهورية العراق. 1968م.
54 - منتدى النشر بعد 16 عاما. جمعية منتدى النشر. النجف الأشرف العراق. 1371ه / 1951م.
55- منهاج الصالحين. السيد محمد سعيد الحكيم. ط 3. مؤسسة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الثقافية. الكويت دولة الكويت. 1998 م.
ص: 681
56 - موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية. الشهيد السيد محمد باقر الحكيم. مؤسسة تراث شهيد المحراب. النجف الأشرف جمهورية العراق. 2005م.
57 - موسوعة عن قتل واضطهاد مراجع الدين وعلماء وطلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية (العراق) 1968 - 2003. د. صاحب الحكيم. ط 1. مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي. النجف الأشرف العراق 1426ه / 2005م.
58 - موسوعة النجف الأشرف. الجزء السادس. جامعة النجف الدينية. جمع بحوثها جعفر الخليلي. الطبعة الأولى. دار الأضواء. بيروت لبنان. 1415ه / 1995م.
59 - الموسوعة الفقهية الميسرة. الشيخ محمد علي الأنصاري. ط1. مجمع الفكر الإسلامي. 19. قم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران 14150ه.
60 - النجف الأشرف مهد الفضيلة والعلم. السيد أحمد المددي. حوار مع مجلة التحقيق والحوزة. إصدار خاص بحوزة النجف الأشرف. مركز الدراسات والبحوث التابع لإدارة الحوزة في قم المقدسة. السنة الرابعة من دون ذكر رقم العدد. قم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران. من دون ذكر سنة الطبع.
61 - النص والاجتهاد. السيد عبد الحسين شرف الدين. تقديم السيد محمد تقي الحكيم. ط4. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. لبنان.1386 ه 1966م.
62- نظام كلية الفقه في النجف الأشرف. جمعية منتدى النشر. مطبعة الآداب النجف الأشرف. العراق. 1958م.
63 - نظرة في علم الأصول في حوزة النجف. حوار مع المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض. مجلة التحقيق والحوزة. عدد خاص بحوزة النجف الأشرف. مركز الدراسات والبحوث التابع لإدارة الحوزة في قم المقدسة. السنة الرابعة. قم. الجمهورية الإسلامية
ص: 682
في إيران. من دون ذكر سنة الطبع.
64 - النور. مجلة دورية شهرية السنة السادسة عشرة. العدد 176. رجب -شبعان 1427ه / آب - أيلول 2006م. لندن. المملكة المتحدة.
65 - هكذا عرفتهم. جعفر الخليلي. منشورات الشريف الرضي. قم. الجمهورية الإسلامية في إيران 14120ه/ 1992م.
ص: 683
ص: 684
دیباجة الطبعة الثالثة ...3
تمهید..11
المرقد العلوي الشريف...11
خط المرقد العلوي الشريف...13
ثانيا - عمارات الحرم العلوي الشريف...14
العمارة الأولى : عمارة هارون العباسي...14
العمارة الثانية : عمارة محمد بن زيد بن إسماعيل الحسني...15
العمارة الثالثة : عمارة السلطان عضد الدولة البويهي...15
العمارة الرابعة : عمارة تشارك بتشييدها أكثر من سلطان...17
العمارة الخامسة: العمارة الصفوية ...17
ثالثا - مميزات العمارة الصفوية القائمة اليوم...18
رابعا - وصف العمارة الحالية للحرم العلوي المطهر، وهي العمارة الخامسة...20
هوامش التمهيد...21
الفصل الأول
المبحث الأول : مصطلح الحوزة العلمية...25
المبحث الثاني: موجز من تاريخ حوزة النجف الأشرف...27
ص: 685
الدور الأول: دور الريادة والتأسيس...34
الدور الثاني: دور تقدم البحث المعرفي...34
الدور الثالث: دور نضج البحث المعرفي...42
الدور الرابع دور نضج البحث المعرفي التحليلي...52
الدور الخامس : دور نضج البحث المعرفي التحليلي والتفكيكي...54
هوامش الفصل الأول...63
الفصل الثاني
تمهيد...91
المبحث الأول: مرحلة المقدمات وكتبها المعتمدة...93
المبحث الثاني مرحلة السطوح وكتبها المعتمدة...99
المبحث الثالث: طريقة التدريس المعتمدة في مرحلتي المقدمات والسطوح...105
هوامش الفصل الثاني...109
الفصل الثالث
المبحث الأول: مرحلة البحث الخارج نظامها وطريقة تدريسها...113
المبحث الثاني : مثلان تطبيقيان تقريبيان من أمثلة...123
درس البحث الخارج في حوزة النجف الأشرف123
هوامش الفصل الثالث...133
الفصل الرابع
المبحث الأول : الاجتهاد في المعجم العربي وفي المصطلح...139
ص: 686
المبحث الثاني: معدات الاجتهاد الشرعي...143
المبحث الثالث : شهادة خريج حوزة النجف الأشرف...149
المبحث الرابع: برنامج يوم عمل الأستاذ مجتهد في حوزة النجف الأشرف...155
أولا - برنامج يوم عمل لسماحة الشيخ باقر الإيرواني...155
ثانيا - برنامج يوم عمل لسماحة الشيخ محمد سند...160
هوامش الفصل الرابع...165
الفصل الخامس
المرجع والمرجعية الدينية...167
المبحث الأول : المرجع الديني وبعض طرائق التحقق من توفر الشروط المطلوبة فيه... 169
المبحث الثاني: المقلد الأعلم وطريقة انتخابه...175
القدرة على تجاوز الحالة القومية والعنصرية في اختيار المرجع الأعلي...185
المبحث الثالث: مهمات المرجعية وانجازاتها...189
المبحث الرابع : برنامج يوم عمل لمرجع سابق ومرجعين حاليين من مراجع حوزة النجف الأشرف ...191
برنامج يوم عمل للمرجع شیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء (قدّس سِرُّه)...192
برنامج يوم عمل للمرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه)... 193
برنامج يوم عمل للمرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام ظلّه) 196
ص: 687
هوامش الفصل الخامس... 199
الفصل السادس
أشهر مراجع التقليد في حوزة النجف الأشرف العلمية الحالية (1432 ه/ 2011م)...203
مقدمة...205
المبحث الأول: المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه)... 207
سيرته الحياتية والعلمية...207
المطلب الأول: ولادته ونشأته العلمية...207
المطلب الثاني كتبه ومصنفاته ومنهجه البحثي في علمي الفقه والأصول...210
المطلب الثالث - بعض من اهتماماته المعرفية الأخرى...216
المطلب الرابع : مرجعيته العامة...218
المطلب الخامس : مشاريعه الإسلامية وخدماته العامة للمؤمنين... 219
المطلب السادس معاناته من النظام البعثي البائد...219
المبحث الثاني : المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه)...223
سيرته الحياتية والعلمية...223
المطلب الأول: ولادته ونشأته العلمية...223
المطلب الثاني : مؤلفاته وكتبه...225
المطلب الثالث: بعض من اهتماماته المعرفية الأخرى...227
المطلب الرابع – مرجعيته...235
المطلب الخامس: مشاريعه الإسلامية وخدماته العامة للمؤمنين... 235
ص: 688
المطلب السادس: محاولة اغتياله الأثيمة...237
المبحث الثالث : المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام ظلّه)...239
سيرته الحياتية والعلمية...239
المطلب الأول: ولادته ونشأته المبكرة...239
المطلب الثاني: مكابدة الوصول إلى النجف الأشرف:...242
المطلب الثالث: دراسته العلمية العالية في النجف الأشرف...244
المطلب الرابع : نشاطه العلمي والتدريسي...245
المطلب الخامس : كتبه ومصنفاته...247
المبحث الرابع : المرجع الشيخ بشير النجفي (دام ظلّه)...251
سيرته الحياتية والعلمية...251
المطلب الأول: اسمه وأسرته...251
المطلب الثاني : دراسته و هجرته العلمية إلى النجف الأشرف وتدريسه...252
المطلب الثالث: منهجه في التدريس وبعض من قناعاته التربوية... 254
المطلب الرابع: كتبه ومؤلفاته...259
المطلب الخامس: مرجعیته ومشاريعه وبعض من اهتماماته المعرفية...259
المطلب السادس: محاولة اغتياله الآثمة...260
هوامش الفصل السادس...263
الفصل السابع
المبحث الأول: الأعداد التقريبية لطلاب حوزة النجف الأشرف
ص: 689
العلمية سابقاً وحالياً...267
المبحث الثاني: أماكن دراسة طلاب حوزة النجف الأشرف... 273
المبحث الثالث : المدارس (الأقسام الداخلية) لطلاب حوزة النجف الأشرف سابقاً وحالياً...279
المدارس الدينية المشغولة في هذه السنة (2011 م / 1432 ه)...286
المبحث الرابع : برنامج يوم عمل لطلاب في حوزة النجف الأشرف...287
هوامش الفصل السابع...295
الفصل الثامن
المبحث الأول : بعض من إيجابيات النظام التدريسي المتبع في حوزة النجف الأشرف...299
المبحث الثاني: بعض من سلبيات النظام التدريسي المتبع في حوزة النجف الأشرف...325
هوامش الفصل الثامن... 335
الفصل التاسع
المبحث الأول : بعض من محاولات إصلاح المنهج التعليمي المتبع في مرحلة المقدمات...343
المطلب الأول: تألیف کتب دراسية جديدة لتحل محل الكتب الدراسية القديمة...343
المطلب الثاني: إجراء تعديل على المنهج التدريسي المتبع في مرحلة المقدمات..345
ص: 690
المبحث الثاني: بعض من محاولات إصلاح المنهج التدريسي المتبع في مرحلة السطوح... 349
مقدمة...349
المطلب الأول: تأليف كتب دراسية جديدة لتحل محل الكتب الدراسية القديمة في علم الفقه...350
المطلب الثاني: تألیف کتب دراسية جديدة لتحل محل الكتب الدراسية القديمة في علم الأصول...357
هوامش الفصل التاسع...379
الفصل العاشر
تصنيف محاولات الإصلاح العام في حوزة النجف الأشرف...383
تصنيف محاولات الإصلاح العام في حوزة النجف الأشرف...385
هوامش الفصل العاشر...389
الفصل الحادي عشر
المبحث الأول: مشروع نظام لمدرسة كاشف الغطاء العلمية للمرجع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء...393
المبحث الثاني: مشروع نظام لمدرسة دار العلم للمرجع الأعلى في وقته السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي (قدّس سِرُّه)...397
هوامش الفصل الحادي عشر... 401
الفصل الثاني عشر
المبحث الأول : بواكير مشروع تأسيس جمعية منتدى النشر...405
ص: 691
المبحث الثاني: البرنامج الاصلاحي الجمعية منتدى النشر بعد التأسيس...409
هوامش الفصل الثاني عشر...455
الفصل الثالث عشر
من جديد أنظمة حوزة النجف الأشرف العلمية...463
الفصل الرابع عشر
المبحث الأول: مدرسة الإمام الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) للطلاب...477
شروط قبول الطالب...480
النظام التعليمي:...480
المنهج الدراسي المتبع:...483
المبحث الثاني مدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية...491
مقدمة...491
أولا - مدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية...493
- فروع المدرسة:...494
- الدراسة المسائية:...496
شروط القبول في المدرسة:...497
مركز دار الحكمة للدراسات الإسلامية:...497
المناهج الدراسية المتبعة للمدرسة حسب المراحل...499
المرحلة التمهيدية :...499
المرحلة الأولى...499
ج- المرحلة الثانية...500
ص: 692
المرحلة الثالثة:...501
المرحلة الرابعة :...501
د- مرحلة السطوح العالية:...502
ثانيا : مدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية - القسم النسوي...503
أولاً : المشرف العام:...503
أولا : المرحلة التمهيدية...506
ثانيا : المرحلة الأولى...506
ثالثا: المرحلة الثانية:...507
رابعا: المرحلة الثالثة...507
خامسا : المرحلة الرابعة...508
سادسا : المرحلة الخامسة:...508
المبحث الثالث: مدرسة دار العلم النسائية للعلوم الدينية...515
مقدمة...515
نظام المدرسة الإداري...516
المنهج التدريسي للمدرسة...517
نصاب المدرسة...519
نشاطات المدرسة...521
الفصل الخامس عشر
مقدمة...525
المبحث الأول: الهيئة العلمية علمية لمؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي...527
ص: 693
اولاً : رئاسة الهيئة العلمية وتشمل :...527
ثانياً : قسم الاصدارات...529
ثالثاً : قسم البحوث...530
شعبة إعداد المناهج :...531
رابعا: قسم الاعلام المرئي...532
سادساً: قسم الاستبيان...533
المطلب الثاني:...535
استبيان العنف ضد المرأة أنموذجا...535
المبحث الثاني...543
(مؤسسة المصطفى للإرشاد والتوعية الدينية)...543
المطلب الأول: دواعي التأسيس...543
المطلب الثاني: أقسام المؤسسة...544
الفصل السادس عشر
المقدمة...549
المبحث الأول: هوية المؤسسة وأهدافه وآليات تحقيق تلك الأهداف...551
2. الأهداف العامة للمؤسسة...551
3. آليات تحقيق المؤسسة لأهدافها...552
المبحث الثاني:...555
نظام المؤسسة...555
أولا - مجلس الإدارة...557
ص: 694
ملاحظات...563
المبحث الثالث:...565
نشاطات المؤسسة...565
أولا - الحلقة العقائدية...565
ثانيا - دورة الفكر المعاصر...566
ثالثا - مشروع الدورة التكميلية الأولى...567
رابعا - الدورة التكميلية الثانية...568
خامسا - سلسلة الندوات التبليغية المتصاعدة...568
سادسا - لقاءات معتمدي المرجعية...569
تاريخ إنشاء المؤسسة ومقرها الدائم...570
الفصل السابع عشر
مؤسسة كاشف الغطاء العامة...573
المبحث الأول: البداية الأولى للتأسيس...573
المبحث الثاني: أقسام المؤسسة...575
قسم الذخائر للمخطوطات:...575
2 - قسم الوثائق والأرشفة:...578
3- قسم التحقيق:...579
4 - قسم الطباعة والنشر:...582
5 - قسم المكتبة العامة :...582
6 - قسم المكتبة الالكترونية :...584
الخاتمة...587
ص: 695
ملاحق الكتاب...591
الملحق الأول...592
صور العتبة العلوية المشرفة...596
الملحق الثاني...608
الملحق الثالث...609
الملحق الرابع...610
الملحق الخامس...612
الملحق السادس...613
الملحق السابع...614
الملحق الثامن...615
الملحق التاسع...616
سماحة المرجع الأعلى...618
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه)...618
سماحة المرجع الديني...618
الشيخ بشير النجفي (دام ظلّه)...618
سماحة المرجع الديني الكبير...618
السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظلّه)...618
سماحة المرجع الديني...618
الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام ظلّه)...618
الملحق العاشر...618
الملحق الحادي عشر...618
ص: 696
أولاً: معاناة المرجعية والحوزة قبل انتفاضة شعبان 1411ه/ آذار 1991م...619
ثانياً: معاناة الأسر العلمية النجفية من ظلم وتعسف النظام البائد (أسرة آل الحكيم أنموذجا)...621
ثالثاً - استمرار ملاحقة واغتيال كبار العلماء وأساتذة حوزة النجف الأشرف...625
رابعاً : النجف الأشرف وانتفاضة شعبان 1411 ه- / آذار 1991 م. ...626
خامسا : أوضاع النجف الأشرف بعد استباحتها من قبل قوات النظام البائد على لسان الشهيد السيد محمد تقي الخوئي (قدّس سِرُّه). ...627
سادساً : مراسم عاشور بعد الانتفاضة على لسان الشهيد السيد محمد تقي الخوئي. ...629
سابعا : هدم المؤسسات والمراكز الشيعية من أمثال الحسينيات والمدارس والمساجد والمكتبات النشطة في أنحاء العراق...630
ثامنا: قلق دولي على مصير كبار علماء الشيعة والمعاهد العلمية الشيعية في أنحاء العراق. ...630
تاسعاً: حظر الشعائر الدينية والاجتماعية لمراجع الدين الشيعة...632
عاشرا: إتلاف ومصادرة ومنع تداول الكثير من الكتب العلمية الشيعية التقليدية وغير التقليدية. ...633
مصادر ومراجع الملحق...637
الملحق الثاني عشر...638
ص: 697
تمهید...638
الملحق الثالث عشر...646
الملحق الرابع عشر...647
الملحق الخامس عشر...648
الملحق السادس عشر...649
الملحق السابع عشر...650
الملحق الثامن عشر...652
الملحق التاسع عشر...653
الملحق العشرون...655
الملحق الحادي والعشرون...656
الملحق الثاني والعشرون...657
الملحق الثالث والعشرون...658
الملحق الرابع والعشرون...659
الملحق الخامس والعشرون...660
الملحق السادس والعشرون...661
مخطط رقم (1)...662
مخطط رقم ( 2)...663
مخطط رقم ( 3 )...664
مخطط رقم ( 4 )...665
جدول رقم (1)...666
جدول رقم (2)...667
ص: 698
الملحق السابع والعشرون...669
الملحق الثامن والعشرون...670
الملحق التاسع والعشرون...671
الملحق الثلاثون...672
الملحق الحادي والثلاثون...673
أهم مصادر الكتاب ومراجعه...675
ص: 699