آثار سماحة آیة العظمی الصافی الگلپایگانی مد ظله الوارف
الصورة

ص: 471
سرشناسه:صافی گلپایگانی، لطف الله، 1298 -
Safi Gulpaygan, Lutfullah
عنوان و نام پديدآور:بیان الاصول/ تالیف لطف الله الصافی الگلپایگانی مدظله العالی.
مشخصات نشر:قم: مکتب تنظیم و نشر آثار آیت الله صافی گلپایگانی دام ظله، 1439 ق.= 1396 -
مشخصات ظاهری:3 ج.
شابک:دوره 978-600-7854-60-0 : ؛ 630000 ریال: ج.1 978-600-7854-57-0 : ؛ 630000 ریال: ج.2 978-600-7854-58-7 : ؛ ج.3 978-600-7854-59-4 :
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
يادداشت:عربی.
يادداشت:چاپ دوم.
يادداشت:ج.2 - 3(چاپ دوم: 1439 ق. = 1396)(فیپا).
يادداشت:کتاب حاضر تقریرات درس آیت الله سیدحسین بروجردی است.
یادداشت:کتابنامه.
یادداشت:نمایه.
موضوع:اصول فقه شیعه
موضوع:* Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction
شناسه افزوده:بروجردی، سیدحسین، 1253 - 1340.
رده بندی کنگره:BP159/8/ص26ب9 1396
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:4942697
اطلاعات رکورد کتابشناسی:فیپا
ص: 1
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 2
ص: 3
بیان الاُصول
تألیف المرجع الديني الأعلى آية اللّه العظمى الشيخ لطف اللّه الصافي الگلپايگاني مدّظلّه العالی
الجزء الأوّل
ص: 4
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير، والسراج المنير، أشرف الأنبياء والمرسلين، سيّدنا أبي القاسم محمد وآله الطيّبين الطاهرين، الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.
وبعد، فمن منن الله تعالى على هذا العبد الحقير أن شرّفه مدّة خمس عشرة سنة في بلدة قم المقدّسة - عشّ آل محمد صلوات الله عليهم - بالاستفادة والاستفاضة من مجالس الإفادة والإفاضة لنابغة الدهر وفقيه العصر، نائب الإمام وأمينه على الحلال والحرام، صاحب الزعامة الكبرى والمرجعية العظمى، محيي الشريعة الغرّاء، وفخر الملّة البيضاء، من كان بالحقّ حجّة عن الحجّة، صاحب المكارم والمناقب والمحامد، اُسوة الزاهدين، وجمال السالكين والمتعبّدين، مولانا السيّد الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي، أعلى الله في فراديس الجنان مقامه.
فكنت بتوفيق الله تعالى وله الحمد والشكر خصّيصاً به، ومستفيضاً من مجالس درسه في الفقه والاُصول ومجالس الإفتاء والفتوى، وسائر مجالسه المليئة بالإفادات الثمينة العلمية، والإفاضات الروحانية.
وقد كان لي ولأخي الأكبر الأمجد اختصاص به، نرى منه كثير التشويق والتقدير والترحيب، يتفحّص عنّا إذا غبنا عن مجلسه.
اللّهمّ املأ مضجعه بأنوار رحمتك الخاصّة الّتي تخصّ بها أولياءك المخلصين، واجعل روحه في أعلى عليّين عند جدّه سيّد المرسلين، صلواتك عليه وعلى أولاده الطاهرين.
ص: 5
هذا، واعلم يا أخي أنّ ما كتبته واستفدته من إفاداته في الاُصول إنّما هو من بحث المشتقّ إلى مبحث البراءة، ولكنّي أضفت إليه الأبحاث المتقدّمة، والّتي كان بعضها من حاشيته القيّمة على الكفاية موجوداً عندي، بعضها الآخر ممّا استخرجته ممّا كتبه عنه غيري، لاسيّما بعض الأفاضل ممّن تتلمّذ عليه في بروجرد((1)) كما أنّي أضفت إليه سائر المباحث من البراءة إلى آخر مبحث الاجتهاد والتقليد؛ ليكون الكتاب شاملاً للمباحث الاُصولية. والله هو الهادي إلى الصواب.
ص: 6
وهي:
الأمر الأوّل: في موضوع العلم
الأمر الثاني: في الوضع
الأمر الثالث: في الاستعمال المجازي
الأمر الرابع: في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، أو صنفه، أو شخصه
الأمر الخامس: في أنّ الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي هي
الأمر السادس: في علائم الحقيقة والمجاز
الأمر السابع: في الصحيح والأعمّ
الأمر الثامن: في المشتقّ
ص: 7
ص: 8
قال(قدس سره): في حاشيته على الكفاية ما هذا لفظه:
قوله(قدس سره): «أمّا المقدّمة ففي بيان اُمور: الأوّل: أنّ موضوع کلّ علم، هو الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية».((1))
أقول: إعلم أنّ أرباب العلوم العقلية والنقلية((2)) بعد اتّفاقهم - سوى من شذّ من متأخّري الاُصوليين - على أنّ لکلّ علم من العلوم موضوعاً على حدة، وأنّ تمايزها إنّما يكون بتمايز تلك الموضوعات، قد اتّفقوا أيضاً على أنّ موضوع کلّ علم هو ما يبحث في هذا العلم عن عوارضه الذاتية. ولازم ذلك هو أنّ موضوع العلم كما يكون جهة امتياز مسائله عن مسائل سائر العلوم، كذلك يكون جهة وحدة لمسائله المختلفة أيضاً، لاشتراك جميعها في كونها باحثة عن عوارض ذلك الموضوع. وأنّه مقدّم في التحصّل على مسائل العلم، لأنّها إنّما تكون مسائله باعتبار كونها باحثة عن عوارضه. وأنّه هو الملاك الفذّ لمعرفة حدّ العلم وغايته أيضاً.
ص: 9
فموضوع العلم على هذا، هو المعلوم الأوّل الّذي يضعه مدوِّن العلم تجاه عقله ليبحث فيما يدوّنه من المسائل عن شؤونه المجهولة، وكأنّهم لذا سمّوه بموضوع العلم، لا لما قد يتراءى من المتن من أنّه الكلي الصادق على موضوعات مسائله، وسيأتي الكلام فيه.((1))
ثم إنّ مرادهم بالعارض في تعريفه كما صرّح به شارح المطالع((2)) وغيره، ويدلّ عليه تتبعّ مسائل العلوم، هو: ما اصطلح عليه المنطقيّون في كتاب إيساغوجي،((3)) وقسّموه إلى الخاصّة والعرض العامّ، وقابلوه بالذاتي المقسّم إلى النوع والجنس والفصل، وهو الخارج المحمول، أي الكلّي الخارج عن الشيء مفهوماً المتّحد معه وجوداً؛ لا ما اصطلح عليه الطبيعيّون، وقسّموه إلى المقولات التسع، وقابلوه بالجوهر، وهو الموجود في الموضوع.
والفرق بينهما من وجوه كثيرة:
منها: أنّ الذاتي والعرضي إضافيّان يمكن صدقهما على مفهوم واحد بالقياس إلى شيئين بخلاف الجوهر والعرض.
ومنها: أنّه يمكن أن يكونا مفهومين کلّ واحد منهما عرضاً للآخر بالمعنى المقابل للذاتي لا بالمعنى المقابل للجوهر، ولذا قالوا: إنّ الجنس عرض عامّ بالإضافة إلى الفصل، والفصل خاصّة غير شاملة بالنسبة إلى الجنس، وهما ذاتيان بالقياس إلى النوع.
وأيضاً: فإنّ العرض المقابل للذاتي يصدق على المفاهيم الزائدة الصادقة على
ص: 10
الجواهر أيضاً، بخلاف المقابل للجوهر.
ومرادهم بالعرض الذاتي هنا: ما كان عروضه للمعروض، أي اتّحاده معه في المرتبة المتأخّرة عن مرتبة الذات لحوقاً أوّلياً بحسب تلك المرتبة، أي لا يكون لحوقه به مترتّباً على لحوق حيثية اُخرى به كذلك حتى يكون هذا متأخّراً عن الذات بمرتبتين بحسب الاعتبار، ويكون مع ذلك عارضاً بتمام ذاته أو بجزئه المساوي.
ويقابله العرض الغريب، وهو العارض للشيء بتوسّط عارض آخر أو بجزئه الأعمّ.
وربما يقال:((1)) إنّ العارض بتوسّط العارض المساوي عرض ذاتي يبحث عنه أيضاً في العلوم، وهو بعيد محتاج إلى التثبّت.
وما يتراءى من تمثيل صاحب الفصول((2)) للعرض الغريب بالسرعة العارضة للحركة العارضة للجسم، وبالشدّة العارضة للبياض العارض للجسم من جملة العرض
ص: 11
على مصطلح الطبيعيّين، و[إطلاق] العرض الذاتي لشيء على ما يعرض نفسه، والغريب على ما لا يعرضه أصلاً بل يعرض لما هو عرض له، قد ظهر بطلانه ممّا بيّناه، مضافاً إلى ما في تمثيله هذا من المناقشات الاُخر الّتي تركناها حذراً من الإطالة.
ثم إنّه یدلّ على ما ذكروه أنّك إذا لاحظت مسائل الفنون المختلفة، وقطعت نظرك عن غير ذواتها، الّتي هي القضايا المرکّبة من موضوعات ومحمولات ونسب، حتى عن مدوِّنها وعن غرضه منه، وعمّا يصدق على موضوعاتها أو على محمولاتها من المفاهيم، رأيت في نظرك هذا بين مسائل کلّ فنّ منها من المناسبة والمشاركة ما لا تراه بينها وبين مسائل غيره، فترى تشارك مسائل النحو فقط في بيان هيأة آخر الكلمة في لغة العرب؛ مسائل الصرف في بيان هيأتها من غير جهة آخرها؛ ومسائل المنطق في بيان أنّ أيّ معلوم صالح للإيصال إلى مجهول وأيّها غير صالح؛ ومسائل العلم الإلهي في أنّ أيّ شيء ممّا نتصوّره موجود في الأعيان، وأيّها غير موجود.
ولا ترى هذا التشارك في غيرها، وهكذا سائر الفنون، وتراها مع ذلك مسائل مختلفة متمايزة بعضها من بعض، فيعلم بذلك أنّها في مرتبة ذواتها ملتئمة من جهة جامعة مشتركة بين جميعها، وجهات مائزة ينفرد كل واحد منها بواحدة منها، وقد حمل فيها إحداهما على الاُخرى. وليس شيء من تلك الجهات المائزة عين الجهة الجامعة ولا جزءها بالضرورة، فهي خارجة عنها مفهوماً، والمفروض هو اتّحادهما وجوداً قضيّة للحمل، فهي عوارض منطقية لها.
فينتج أنّ لمسائل کلّ فنّ من الفنون جهة جامعة يشترك جميعها في البحث عن عوارضها المنطقية، وأنّ تلك الجهة بعينها مائزة بينها وبين مسائل سائر الفنون لفرض كونها فاقدة لها، وهذا هو المطلوب.
وينبغي التنبيه على أمرين:
ص: 12
الأوّل: أنّ مسائل العلم ليست منحصرة في القضايا الموجبة الّتي تكون الجهات المائزة فيها عوارض واقعية لموضوع العلم، بل تشمل سوالبها أيضاً وإن كان مفادها سلب العروض، فإنّ البحث عن عوارض الموضوع يستدعي البحث عن كلّ ما قيل أو يحتمل أنّه من عوارضه، سواء أدّى إلى الإثبات أو النفي.
الثاني: أنّ الجهة الجامعة الّتي ذكرنا أنّها هي موضوع العلم لا يلزم وقوعها موضوعة في مسائل العلم.
وتقدّم أنّ تسميته به ليست بهذا الإعتبار بل الغالب في المسائل هو حمل هذه الجهة على الجهات المائزة لكونها أعمّ منها، ومن هنا ترى أنّ مفهوم المنتج لكذا وهو المرادف للموصل إلى المجهول يحمل في مسائل المنطق على ضروب الأشكال، والموجود بما هو موجود مع أنّه موضوع للفلسفة الكلّية يقع محمولاً في مسائلها على ما يبحث فيها عن وجوده.
وقصر بعضهم مسائلها على قضايا معدودة ذكرها هو، وجعل موضوعها الموجود بما هو موجود، ومحمولها ما زعم أنّه من عوارضه من العلم والقدرة والعليّة وأشباهها، مخالف لما صرّح به أعاظم الفن في مواضع كثيرة:
منها: ما ذكره المحقّق الطوسي في الطبيعيّات من شرح الإشارات، حيث عدّ مسألة وجود المادّة والصورة من مسائل العلم الإلهي، واعتذر عن ذكرها هناك بما اعتذر.((1))
إن قلت: ما ذكرته من وقوع الجهات المائزة موضوعة في المسائل ينافي ما مرّ من أنّها عوارض لموضوع العلم، وأنّ العارض هو الخارج المحمول.
قلت: الحمل هو الاتّحاد في الوجود وهو بالنسبة إلى الطرفين على السواء.
إن قلت: كيف تكون أخصّ من الجهة الجامعة مع أنّها عوارض ذاتيّة لها، وما بالذات لا يتخلّف؟
ص: 13
قلت: كونها ذاتيّة ليس بمعنى كون الذات علّة لها حتى يمتنع تخلّفها عنها، بل بمعنى أنّه لا واسطة بينهما في العروض كما مرّ، وقد قالوا: إنّ الفصول عوارض ذاتيّة للجنس مع أنّها أخصّ منه.
قوله(قدس سره): «أي بلا واسطة في العروض».
أقول: تعريف العرض الذاتي بهذا كأنّه غير مطّرد، لصدقه على ما يعرض الشيء بواسطة جزئه الأعمّ مع أنّه عرض غريب. اللّهمّ إلّا أن يقال: بشمول الواسطة في العروض للجزء أيضاً، فتأمّل.
قوله(قدس سره): «هو نفس موضوعات مسائله عيناً، وما يتّحد معها خارجاً، وإن كان يغايرها مفهوماً، تغاير الكلّي ومصاديقه، والطبيعي وأفراده. والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض... إلخ».
أقول: إردافه(قدس سره) تفسير موضوع العلم على طبق ما ذكره القوم بهذا الكلام يهدم أساس موافقته لهم، فإنّ محصّل مجموع كلامه حينئذٍ صدراً وذيلاً هو:
أنّ کلّ فنّ من الفنون عبارة عن جملة من قضايا لا مشاركة بينها في موضوع ولا محمول، بل هي متباينة بتمام ذواتها كتباينها مع مسائل سائر الفنون، ولكنّها مع تباينها كذلك تترتّب على مجموعها غاية واحدة هي الغرض من تدوينها، وبمداخلة جميعها في ذلك الغرض استحقّت لأن تجعل فنّاً واحداً ممتازاً عن سائر الفنون، ويكون أيضاً لموضوعاتها جامع واحد يصدق عليها صدق الطبيعي على أفراده. ولمّا كان محمول كلّ مسألة منها عرضاً ذاتياً لموضوعها الّذي هو فرد لهذا الجامع كانت محمولاتها عوارض ذاتية له أيضاً، فيصدق أنّه يبحث فيها عن عوارضه الذاتية، فيكون هو موضوعاً لذلك الفنّ وإن لم يكن له اسم ولا رسم ولا يتصوّره المدوِّن ولا غيره ولا يكون البحث في
ص: 14
مسائله راجعاً إليه.
ويرد عليه أوّلاً: ما تقدّم من أنّ مسائل الفنّ الواحد ليست متباينة بتمام ذاتها، بل لها جهة جامعة بنفسها لا بأفرادها - أحد جزئيها- .
وثانياً: أنّ محمولات المسائل بعد فرض كونها عوارض ذاتية لموضوعاتها، لا يمكن كونها عوارض ذاتية للكلّيّ الجامع بينها؛ إذ لخصوصياتها المائزة دخل في عروضها. اللّهمّ إلّا أن يفسّر العرض الذاتي بما حكيناه عن الفصول، وقد مرّ أنّه غير متّجه.((1))
وثالثاً: أنّ اندراج موضوعات المسائل تحت كلّيّ صادق عليها صدق الطبيعي على أفراده، بعد فرض عدم صيرورته منشأً لوحدة المسائل وعدم اشتراكها بسببه في جهة جامعة، لعدم رجوع البحث فيها إليه وعدم دخله في وحدة الغرض منها الّتي هي المناط في كونها فنّاً واحداً ممتازاً عن غيره على ما أفاده، بل وعدم تصوّر أحد له - لعدم اسم له ولا رسم - أيّة فائدة تترتّب على ثبوته. وأيّ فرق يتصوّر بين أن يكون وبين أن لا يكون حتى يلزمنا القول بثبوته، فهل هو حينئذٍ إلّا كالحجر بجنب الإنسان؟ ثمّ بأيّ دليل يمكننا إثباته مع أنّ الدليل قائم على خلافه في أكثرها، فهل يمكن وجود جامع بين موضوعات مسائل العلم الإلهي يكون كلّياً طبيعيّاً لها مع أنّ بعضها واجب لذاته وبعضها ممكن؟
ورابعاً: أنّ ترتّب الغاية الواحدة على المسائل المتباينة بتمام الذات غير معقول، فإنّ غرض المدوِّنين من تدوين المسائل ليس إلّا حصول العلم بها، سواء كان العلم بها مطلوباً لذاته كما في العلم الإلهي أو مقدّمة للعمل كما في أكثر الفنون، ومعلوم أنّ وحدة العلم نوعاً أو شخصاً وتعدّده تابعة للمعلوم، فما لم يكن للمسائل المختلفة جهة
ص: 15
وحدة لم يكن للعلم بها تشارك واتّحاد.
إن قلت: مراده بالغرض الواحد هو مجموع الأغراض المترتّبة على مجموع المسائل، ووحدته حينئذٍ شخصية اعتبارية كوحدة سائر المركّبات الاعتبارية، ولذا قال: «جمعها إشتراكها في الدخل في الغرض»، وليست هذه الوحدة مترتّبة على وجود الجهة الجامعة بين المسائل.
قلت: لا يمكن كون وحدة الغرض بهذا المعنى ملاك تمايز العلوم، إذ کلّ جملة من المسائل يكون لا محالة لمجموع أغراضها وحدة كذلك وإن لم تكن من سنخ واحد، فيسأل حينئذٍ أنّه لم جعل هذه الجملة فنّاً واحداً واعتبرت أغراضها واحدة كذلك؟ ولا جواب عنه إلّا بأن يقال: إنّ أغراضها من سنخ واحد، بخلاف غيرها، فيرجع إلى وحدتها النوعية الّتي ذكرنا أنّها مترتّبة على ثبوت جهة الوحدة في نفس المسائل.
قوله(قدس سره): «لا الموضوعات ولا المحمولات، وإلّا كان کلّ باب، بل كلّ مسألة من کلّ علم علماً على حدّة».
أقول: فيه أنّهم قالوا: إنّ کلّ واحد من الفنون المدوَّنة يكون له موضوع خاصّ هو جهة وحدة مسائله وامتيازه عن غيره، لا أنّ كلّ جملة من المسائل إذا كان لها جهة وحدة كذلك، يلزم أن يجعل فنّاً على حدة حتى يرد عليه ما ذكر. مع أنّ هذا مشترك الورود، إذ الغرض من كلّ باب بل کلّ مسألة ممتاز عن الغرض من غيره.
ثم إنّ قوله: «ولا المحمولات» لعلّه إشارة إلى ما ذكره صاحب الفصول من أنّ امتياز العلوم يكون بامتياز الموضوعات أو حيثيّات البحث، زعماً منه أنّ موضوع النحو والصرف واحد وهو الكلمة والكلام، وإنّما يمتازان بأنّ البحث عنهما في النحو من حيث الإعراب والبناء، وفي الصرف من حيث الصحّة والاعتلال.((1))
وهو غير وجيه، فإنّ الحيثيّتين مأخوذتان في موضوعيهما. وحقيقة الأمر هي ما
ص: 16
أشرنا إليه سابقاً من أنّ موضوع النحو هو: هيأة الكلمة من جهة آخرها، وإليها أشاروا بقولهم: من حيث الإعراب والبناء، وموضوع الصرف هو: هيأتها من غير جهة آخرها، وهي المراد بقولهم من حيث الصحّة والاعتلال، وإنّما عبّروا بما ذكر تقريباً إلى فهم المبتدئين.
قوله(قدس سره): «وقد انقدح بذلك أنّ موضوع علم الاُصول، هو الكلّيّ المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة، بل ولا بما هي هي...إلخ».
{أقول}:((1)) الاُصوليّون بعد ما تسالموا على ما تسالم عليه غيرهم من أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وأ نّه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، قالوا: إنّ موضوع اُصول الفقه هو أدلّة الفقة. ومرادهم بها أدلّته بما هي أدلّته. ومرادهم بالدلالة هو الحجّية، فمرجع كلامهم حينئذٍ إلى أنّ موضوعه هو حيثيّة «الحجّة في الفقه».
ولذا استشكله المحقّق القمّي(رحمه الله) في «الحواشي» بأنّ لازمه خروج المسائل الباحثة عن حجّية الحجج كخبر الواحد والإجماع ونحوهما عن مسائل هذا العلم، ودخولها في مباديه، إذ الحجّية على هذا مقوّم للموضوع لا من عوارضه.((2))
ودفعه في الفصول بالتزام أنّ موضوعه هو ذوات الأدلّة الأربعة، لا بما هي أدلّته حتى يلزم ما ذكر.((3))
وفيه مضافاً إلى استلزامه كون موضوع الفنّ الواحد أربعة اُمور متباينة، بل وأكثر أو أقلّ على الخلاف فيه أنّه لو كان كذلك لكان يبحث فيه عن جميع عوارض الأربعة
ص: 17
لا عن الحجّية فقط. مع أنّه لا ينفع في إدخال مسألة حجّية الخبر فيها لأنّ الحجّية من عوارض الخبر لا السنّة، كما ذكره(قدس سره) في المتن وأطال الكلام فيه.
وكأنّ استصعاب دفع هذا الإشكال هو الّذي دعا شيخنا العلّامة(قدس سره) إلى العدول عن ذلك إلى ما قال: من أنّ موضوعه بل موضوع عامّة العلوم هو: الكلّيّ الجامع بين موضوعات مسائله وإن لم يكن له اسم ولا رسم. ولأجل منافاة هذا لكون تمايزها بتمايز الموضوعات، لاقتضائه تقدّم المسائل على الموضوع في التحصل عدل عنه أيضاً إلى أنّ تمايزها بالأغراض لا بالموضوعات.
وأنت بعد الإحاطة بما بيّناه تعلم أنّ هذا الإشكال إنّما نشأ من عدم تحصيل مراد القوم من موضوع العلم ومن عوارضه الذاتية، وتوهّم أنّ موضوع العلم يلزم أن يقع موضوعاً في المسائل أيضاً.
فالحقّ في الجواب عنه هو: أنّ وقوع الحجّة محمولة في تلك المسائل لخبر الواحد والإجماع ونحوهما، لا ينافي كون البحث فيها عن عوارض الحجّة، فإنّ عوارضها الّتي بحثوا في هذه المسائل عن عروضها لها، أي اتّحادها معها في نفس الأمر، هي خبر الواحد والإجماع وغيرهما ممّا وقع موضوعاً فيها لا الحجّية حتى يقال: إنّها مقوّمة للموضوع، بل الظاهر أنّ هذه القضايا الباحثة عن حجّية شيء وعدم حجّیته هي المسائل لهذا العلم فقط. ولذا اقتصر الشافعي في رسالته - الّتي صنّفها في ذلك العلم في أواخر القرن الثاني، وهي أوّل ما صنّف فيه فيما نعلم - على ذكر مسألة حجّية الكتاب والسنّة غير المنسوخين، والإجماع وخبر الواحد والقياس والاجتهاد والاستحسان. نعم، أطال الكلام في نسخ الكتاب والسنّة وفروعه. ثم زاد من جاء بعده على ما ذكره أشياء من سنخها وأشياء اُخر من غير سنخها إمّا على وجه الإستطراد أو من باب المبادي.
فظهر بما ذكرناه أنّ مسائل حجّية القطع والظنّ على
ص: 18
القول بها، وحجّية الأمارات الحاكية عن الواقع بلا معارض أو مع المعارض، وحجّية الاحتمالات غير الحاكية عنه كاحتمال بقاء ما ثبت في الاستصحاب المثبت للتكليف، كلّها من مسائل هذا العلم، وكذا المسائل النافية لحجّية ما احتمل حجّیته أو قيل بها مثل القياس والاستحسان والاجتهاد، وبعض ما مرّ على القول بعدم حجّیته، بل ومن هذا القسم أيضاً مسألة أصالة البراءة في الشبهة البدويّة فإنّ مرجعها إلى عدم حجّية احتمال التكليف بالنسبة إلى التكليف المحتمل وعدم تنجّزه به على تقدير ثبوته واقعاً.
هذا إذا قلنا بأنّ المراد بالحجّة ما كان للمولى على العبد، وأمّا إذا عمّمت لعكسه فهي من مسائله.
ثم ليعلم: أنّ مسألتي أصالة الاشتغال والتخيير أيضاً مرجعهما إلى البحث عن الحجّية وإثباتها بتقريب: أنّ ما ثبت حجّیته من العلم والأمارات وغيرهما يكون حجّة على الواقع مطلقاً سواء علم متعلّقها تفصيلاً أو تردّد بين أمرين أو اُمور، فإن أمكنت الموافقة القطعية لزمت عقلاً وهو أصالة الاشتغال، وإلّا فإن أمكنت الموافقة الاحتمالية - بکلا شقّيها - والمخالفة القطعية، كان اللازم هو الموافقة الاحتمالية وتخيّر بين شقّيها مع عدم المرجّح، وهو أصالة التخيير. وإن لم يكن شيء منهما، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة بلا مرجّح، كانت الحجّة على الواقع مسلوبة كما في أصالة البراءة. نعم، المسلوب هناك هو حجّية احتمال التكليف، وهنا حجّية الحجّة الإجمالية كذلك، فتفطّن.
فظهر أنّ مسائل الاُصول العمليّة ليست من سنخ آخر، ولا الغرض منها أمراً آخر غير ما هو الغرض من مسائل حجّية الأدلّة كما يتراءى من المتن، بل ويمكن على هذا التقرير إدراج جملة من مباحث الألفاظ في مسائل هذا العلم أيضاً.
بيانه: أنّ الأقدمين لمّا كانت حجّية دلالة الألفاظ عندهم واضحة، لم يبحثوا عنها بحثاً واحداً كلّياً، لكن لمّا احتملوا عدم حجّية جملة منها، إمّا لضعفها كالدلالات
ص: 19
المفهومية الناشئة من ذكر القيد، والإطلاقية الناشئة من عدم ذكره، أو لوجود ما احتملوا مانعيته منها كما في العامّ المخصَّص أو المطلق المقيَّد، أو لاحتمال اعتبار شيء فيها كالفحص عن المخصّص أو عن قرينة المجاز، عقدوا لکلّ منها مسألة. فالبحث فيها يرجع إلى البحث عن حجّية دلالة الألفاظ إذا كانت بهذه الخصوصيّة.
قوله(قدس سره): «يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام».
أقول: إدراج مسائل حجّية الأدلّة في هذا مشكل، إذ استنباط الحكم الواقعي في مواردها على وجه القطع غير ممكن، وعلى وجه الظنّ حاصل من دون دخالة لها فيه؛ والحكم الظاهري هو عينها لا أنّها تقع في طريق استنباطه.
ص: 20
قوله(قدس سره): «الوضع هو: نحو اختصاص للّفظ بالمعنى، وارتباط خاصّ بينهما((1)) ناشٍ من تخصيصه به تارة، ومن كثرة استعماله فيه اُخرى».
أقول: أراد بالوضع، كون اللفظ موضوعاً للمعنى على أن يكون مصدراً مبنيّاً للمفعول أو اسم مصدر.
وأراد بالاختصاص، كونه ذا خصوصيّة وارتباط بالنسبة إلى المعنى، لا كونه مختصّاً به حتى يخرج وضع المشتركات.
ص: 21
ولم يبيّن نوع الخصوصيّة، إذ هو من شرح الاسم، والغرض منه الإشارة إلى ما هو المراد من المعاني الحاضرة في الذهن، لا بيان ماهية مجهولة. وعدل عمّا هو المعروف من أنّه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه،((1)) لعدم شموله للتعيّني ولا لوضع الإنشاءات؛ مع أنّ هذا هو المعنى الّذي تترتّب عليه أحكام الوضع من الحجّية وغيرها وتؤدّي إليه أماراته لا ما ذكروه.
فحاصله: أنّ كون اللفظ موضوعاً لمعنى عند قوم، هو كونه عندهم آلة لهذا المعنى إفهاماً أو إنشاءً، وتقسيمه حينئذٍ إلى التعييني والتعيّني تقسيم له باعتبار مسبّبه، لكنّ الوضع بهذا المعنى ليس غير الدلالة الشأنية، كما لا يخفى.
قوله(قدس سره): «ثم إنّ الملحوظ حال الوضع: إمّا يكون معنىً عامّاً، فيوضع اللفظ له تارة ولمصاديقه اُخرى؛ وإمّا يكون معنىً خاصّاً، لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ له».
أقول: لمّا كان الوضع نسبة بين اللفظ والمعنى كان التعييني منه موقوفاً على تصوّر الواضع كلّاً منهما حتى يضع هذا لذاك، فباعتبار ملاحظته المعنى ووضعه اللفظ له قسّموه إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في المتن، وباعتبار ملاحظته اللفظ ووضعه إيّاه للمعنى قسّموه أيضاً إلى الوضع الشخصي والنوعي، فقالوا: إن تصوّر لفظاً خاصّاً ووضعه لمعنى فهو شخصي، وإن لاحظ عنواناً كلّياً صادقاً على ألفاظ كثيرة فوضع كلّ فرد من أفراده الملحوظة إجمالاً بلحاظه لمعنى فهو نوعي، ومثّلوه بوضع صيغ الأفعال والأوصاف، وذلك لأنّهم لمّا رأوا أنّ الفعل الموزون بزنة «فَعَلَ» بالفتحات الثلاث مثلاً معناه مع قطع النظر عن اختلاف الموادّ واحد، وهو قيام معنى مصدره بمعنى الاسم المرفوع بعده إذا كان مفرداً مذكّراً في الزمان الماضي، واستبعدوا أن يكون الواضع وضع كلّ واحد من أفراده لهذا المعنى المتشابه بوضع مستقلّ على حدّة، تحدّسوا من ذلك أنّه
ص: 22
لاحظ هذا المفهوم الكلّي ووضع کلّ فرد منه - من أيّ مصدر كان - لقيام معناه بما بعده كذلك بوضع واحد ينحلّ إلى أوضاع كثيرة، وهكذا غيرها من الصيغ.
وعلى هذا فلك أن تقول: إنّه لا يتعيّن أن يكون الموضوع لذلك المعنى مجموع المادّة والهيأة من «ضرب» بالفتحات الثلاث مثلاً، حتى يقال: إنّ الواضع لاحظه وسائر ما يكون على وزنه إجمالاً بلحاظ مفهوم الموزون هكذا، إذ يمكن أن يكون الموضوع لهذا المعنى هيأته الّتي تقوم بنفسها بموادّ المصادر، وهي بنفسها ملحوظة للواضع تفصيلاً بنفسه، لا بمفهوم آخر صادق عليها وعلى غيرها، وعليه فيكون وضعها شخصياً وإن كانت هي كلّية لصدقها على حصصها القائمة بکلّ مادّة من الموادّ وعلى أشخاصها، ولعلّه لهذا ترك المصنف(قدس سره) ذكر هذا التقسيم.
قوله(قدس سره): «وأمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فقد توهّم((1)) أنّه وضع الحروف، وما اُلحق بها من الأسماء،((2)) كما توهّم أيضاً أنّ المستعمل فيها((3)) يكون خاصّاً مع كون الموضوع له كالوضع عامّاً، والتحقيق: أنّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيهما حالهما في الأسماء».
أقول: تحقيق كيفية وضع الحروف من هذه الجهة موقوف على بيان معانيها، وتوضيح جهة الفرق بينها وبين الأسماء الّتي تذكر في مقام تفسيرها على وجه يتراءى منه ترادفها، كلفظتي «من» و«الابتداء» أو «إلى» و«الانتهاء» أو «في» و«الظرفية» وأشباهها، مع أنّا نرى أنّه لا يصحّ استعمال أحدهما في موضع الآخر، ولا وقوع «من» و«إلى» و«في»
ص: 23
محكوماً عليه أو به كما يقع الابتداء والانتهاء والظرفيّة كذلك. ومعلوم أنّه ليس ذلك إلّا لفارق وضعيّ بينهما وهو ينافي الترادف وصحّة تفسير أحدهما بالآخر.
والحاصل: أنّ معنى «من» و«الابتداء» مثلاً، إن كان واحداً كان اللازم صحّة استعمال کلّ منهما في موضع الآخر وجواز وقوع «من» محكوماً عليه وبه كالابتداء، لکنّه لا يجوز. وإن لم يكن واحداً لم يصحّ تفسير «من» بالابتداء، لکنّه صحيح لعدم فهم العرف منها سوى الابتداء، وصحّة الملازمتين كبطلان التاليين واضحة، فينتجان بطلان المقدّم في كلتي الشرطيّتين، وهو ارتفاع النقيضين، وبطلانه ضروري. وهذه عقدة((1)) صعب حلّها على كثير من الأفهام واختلفت عبارات أهل النظر في الجواب عنها.
فقال الرضيّ(رحمه الله) في شرح ما قالوه من «أنّ الاسم ما دلّ على معنى في نفسه، والحرف ما دلّ على معنى في غيره» بعد ما أرجع ضميري نفسه وغيره إلى «ما» المراد بها الكلمة، وأبطل إرجاعهما إلى المعنى،((2)) ما هذه عبارته: «إنّ معنى «من» الابتداء، فمعنى «من» ومعنى لفظ الابتداء واحد،((3)) إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر، بل مدلوله معناه الّذي في نفسه مطابقة،
ص: 24
ومعنى «من» مدلول((1)) لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي، فلهذا جاز الإخبار عن لفظ «الابتداء» في قولك: «الابتداء خير من الانتهاء»، ولم يجز الإخبار عن لفظ «من» لأنّ الابتداء الّذي هو مدلولها في لفظ آخر، فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيه بل في لفظ غيره؟ وإنّما يخبر عن الشيء باعتبار المعنى الّذي في نفسه مطابقة. فالحرف وحده لا معنى له أصلاً، إذ هو كالعَلَم المنصوب بجنب شيءٍ ليدلّ على أنّ في ذلك الشيء فائدة مّا، فإذا أفرد عن ذلك الشيء بقي غير دالّ على معنى [في شيء((2))] أصلاً».
ثم اعترض على نفسه: بأنّ «طويلاً» في قولك: «رأيت رجلاً طويلاً» موجد لمعناه وهو الطول، في لفظ آخر وهو «رجلاً»، مع أنّه ليس بحرف.
وأجاب: بأنّ معناه ليس هو الطول فقط، بل من له الطول مأخوذ فيه أيضاً على وجه الإجمال، وإنّما يتعيّن بالموصوف.
ثم اعترض بالمصدر المضاف كضرب زيد، إذ ليس من له الضرب مأخوذاً فيه، فهو موجد لمعناه في لفظ غيره.
وأجاب: بأنّه وإن كان كذلك في المثال، لكنّ المصدر لم يوضع لذلك، لصحّة قولنا: «الضرب شديد» بدون الإضافة إلى من له الضرب.((3)) انتهى ما أردناه.
ويرد عليه بظاهره، مضافاً إلى أنّه لم يزد المطلب إلّا إعضالاً، أنّ هذا المعنى بعد فرض وحدته، كيف يكون إذا أفاده لفظ «الابتداء» مدلولاً لنفسه وإذا أفادته لفظة
ص: 25
«من» مدلولاً للفظ آخر منضافاً إلى مدلوله الأصلي؟ مع أنّ هذا لا يخلو من تهافت بل لا يتصوّر له معنىً معقول.
وقال بعض من تأخّر((1)) عنه، في توضيح ما ذكره بعضهم في شرح التعريفين المذكورين، بعد إرجاع الضميرين فيهما إلى المعنى، من قوله: أي ما دلّ على المعنى بلحاظه في نفسه، أو لا بلحاظه في نفسه بل في متعلّقه، ما هذه عبارته بأدنى تغيير: «كما أنّ في الخارج موجوداً قائماً بذاته وموجوداً قائماً بغيره، كذلك في الذهن معقول هو مدرَك قصداً ملحوظاً في ذاته يصلح لأن يحكم عليه وبه، ومعقول هو مدرَك تبعاً وآلة لملاحظة غيره فلا يصلح لهما، فالابتداء مثلاً إذا لوحظ قصداً وبالذات كان معنىً مستقلاً بالمفهومية، ولزمه تعقّل متعلّقه إجمالاً وتبعاً من غير حاجة إلى ذكره، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء، بلا حاجة إلى ضمّ ما یدلّ على متعلّقه؛ وإذا لوحظ من حيث هو حالة بين السير والبصرة مثلاً وجعل آلة لتعريف حالهما كان معنىً غير مستقلّ بالمفهومية، ولا يصلح لأن يحكم عليه وبه، ولا يتعقّل إلّا بتعقّل متعلّقه بخصوصه، ولا يمكن أن یدلّ عليه إلّا بضمّ ما یدلّ على متعلّقه.
والحاصل: أنّ لفظ «الابتداء» موضوع لمعنى كليّ ولفظة «من» لكلّ واحد من جزئياته المخصوصة المتعلّقة من حيث إنّها حالات لمتعلّقاتها، وآلات لتعرّف أحوالها، وذلك الكلّي يمكن أن يتعقّل قصداً ويلاحظ في حدّ ذاته فيستقلّ بالمفهومية ويصلح أن يحكم عليه وبه، بخلاف تلك الجزئيّات فلا تستقلّ بها ولا تصلح لهما».((2)) انتهى.
ص: 26
وبمثل هذا فرّق بينهما شيخنا العلّامة(قدس سره) أيضاً في مواضع من هذا الكتاب((1)) وغيره، لکنّه كما ترى أنكر كون «من» موضوعة للجزئيات. ولعلّ الظاهر من كلام ذاك القائل أيضاً أنّ مناط الفرق ليس هو الكلية والجزئية، بل اللحاظ على وجه الاستقلال والآلية، لکنّه زعم أنّ الثاني لا يكون إلّا في جزئياته، فهو حينئذٍ بحث آخر يأتي بيانه.
ثم إنّ هذا البيان وإن كان أقلّ إعضالاً من الأوّل، لکنّه لعدم بيانه حقيقة هذين اللحاظين ربما يورد عليه: بأنّ هذا المعنى الواحد كيف يلحظ تارة قصداً وبالذات، واُخرى حالة بين شيئين وتبعاً لهما وآلة لتعرّف حالهما؟ وأيّ معنى لهذين اللحاظين؟ وأيضاً فهذا المعنى الّذي ليست ماهيته إلّا الإضافة بين شيئين، كيف يسلب عنه ذلك ويصير معنىً ملحوظاً على وجه الاستقلال؟ وهل يكون هذا إلّا سلباً للشيء عن نفسه؟
وذكر بعض المتأخّرين:((2)) أنّ لفظ الابتداء والانتهاء والظرفيّة وأشباهها موضوعة للإضافات المخصوصة الّتي تفهم منها، ولفظة «من» و«إلى» و«في» للارتباطات الحاصلة بين معاني المتعلّقات بسبب هذه الإضافات. انتهى.
وربما يورد عليه: بأنّ الإضافات المذكورة وأشباهها ليست ماهيّاتها إلّا الارتباطات بين المعاني، فليست الارتباطات بينها شيئاً غيرها حتى يصحّ جعلها معاني للأسماء، وجعل الارتباطات الحاصلة بها معاني للحروف.
ولعلّ منشأ هذه الإيرادات هو عدم وفاء عباراتهم بأداء مقاصدهم على ما هو حقّه، وإلّا فبعد تحقيق المسألة يتبيّن أنّه يمكن تنزيل جميعها عليه.
ص: 27
فتحقيق المقام هو:
إنّ ارتباط أحد الأمرين إلى الآخر جوهرين كانا أو عرضين أو مختلفين، وكلّيّين كانا أو جزئيّين أو مختلفين، بأيّ نحو من أنحاء الارتباط من العليّة والمعلوليّة، والتقدّم والتأخّر، والظرفيّة والمظروفيّة، والأوّلية والآخريّة، وأشباهها لا تحقّق له في نفس الأمر بغير وجود طرفيه بما لهما من الخصوصيّة هو المنشأ لانتزاع تلك الإضافات، ولا معنى لتحقّقها في نفس الأمر سوى ذلك.
نعم، للعقل أن ينتزعها من خصوصيّة الطرفين، ويتصوّرها أشياء بحيالها وعلى وجه الاستقلال، لکنّها حينئذٍ تخرج عن كونها ارتباطاً بين شيئين بالحمل الشائع وإن كان ارتباطاً بالحمل الذاتي. فكون شيئين مرتبطين بالحمل الشائع لا يكون في الخارج ولا في الذهن إلّا بأن يكون الارتباط مندكّاً فيهما موجوداً بعين وجودهما.
ولمّا كانت الحاجة ماسّة في المحاورات إلى تفهيم الارتباطات على كلا الوجهين، فتارة: يريد تصويرها للمخاطب في نفسها بحيث يتصوّرها ممتازة عن غيرها من المفاهيم، واُخرى: يريد تصوير طرفيها مرتبطين بشيءٍ من الارتباطات، فلا جرم كانت الألفاظ الموضوعة لها قسمين:
فمنها: ما وضع لإفادتها بعد انتزاعها من طرفيها، وصيرورتها أشياء بحيالها. وهذا القسم يكون كسائر الألفاظ الدالّة على المعاني المستقلّة من الجواهر والأعراض، متى سمع شيء منها فهم معناه بلا حاجة إلى غيره.
ومنها: ما وضع لإفادتها حال كونها ارتباطاً حقيقيّاً بالحمل الشائع، أي وضع ليفيد كون الطرفين مرتبطين كذلك. ولا يمكن ذلك إلّا بأن يكون موضوعاً لأن يجعل في الكلام بجنب اللفظين الدالّين على طرفي الارتباط، لا لأن يتصوّر بحذائه ذلك الارتباط حتى يخرج عن كونه ارتباطاً حقيقيّاً، وينتقض الغرض، بل لأن يفهم بسببه
ص: 28
ما يفهم من اللفظين من المعنى متخصّصين بخصوصيّة تكون منشأً لانتزاع ذلك الارتباط منهما إذا نظر إليهما العقل بنظر آخر غير هذا النظر الّذي يكون الارتباط بحسبه ارتباطاً بالحمل الشائع ومندكّاً في الطرفين. فهذا القسم هي الحروف الدالّة عليها، والقسم الأوّل أسماؤها.
ويدلّ على ذلك أنّك إذا سمعت قائلاً يقول: «السير»، «الصدور»، «زيد»، «الابتداء»، «البصرة»، «الانتهاء»، «الكوفة» تصوّرت معاني بعضها جواهر وبعضها أعراض وبعضها ارتباطات بالحمل الذاتي، من [دون] أن تفهم أنّ شيئاً منها مرتبط إلى آخر بشيءٍ من الارتباطات.
وإذا سمعته يقول: «سار زيد من البصرة إلى الكوفة» فهمت وجود سير مرتبط إلى زيد بصدوره منه، وإلى البصرة والكوفة باقتطاعه عندهما أوّلاً وآخراً؛ فيعلم بذلك أنّ ألفاظ «الصدور» و«الابتداء» و«الانتهاء» توجب تصوّر تلك المفاهيم المنتزعة المستقلّة، بخلاف هيأة الفعل والفاعل و«من» و«إلى» الواقعتين بين المتعلّق والمجرور، فإنّها تفيد السير المرتبط إلى زيد والبصرة والكوفة، أي تفيد منشأ انتزاع هذه المفاهيم. ولهذا لا يصحّ استعمال کلّ منهما في موضع الآخر؛ لأنّ كيفيّة عملهما في المعنى مختلفة، بل في غاية المباينة. ولا يمكن وقوع الحرف محكوماً عليه وبه؛ إذ ليس له معنىً متصوّر بحذائه حتى يحكم عليه أو به، وما يفيده أمر مندكّ في معنى طرفيه، ولذا قال الرضيّ: فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيه بل في لفظ آخر، بخلاف القسم الأوّل؛ فإنّ معناه أمر متصوّر يكون بحذائه. ولا ينافي ذلك قولهم: «من» للابتداء، فإنّه في مقام بيان ما تفيده لفظة «من» من أنحاء الارتباطات، فلابدّ من ذكر ما يفيده تصوّراً بعد الانتزاع، وهو لفظ الابتداء.
فظهر بما ذكرناه أنّ لفظة «من» لا يقع بحذائها شيء من المعنى مطلقاً، بل ولا تفيد
ص: 29
أيضاً فائدة إلّا إذا ضمّت إلى لفظي الطرفين، فحينئذٍ تفيد تخصّص الطرفين بما ذكرناه من الخصوصيّة. وهذا هو مراد الرضيّ(قدس سره) بقوله: «فالحرف وحده لا معنى له أصلاً، إذ هو كالعَلَم المنصوب بجنب شيءٍ ليدلّ على أنّ فيه فائدة مّا، فإذا افرد عنه بقي غير دالّ على معنى في شيءٍ»، وقوله: «ومعنى «من» مدلول لفظ آخر ينضاف إلى معناه الأصلي». فاندفع بهذا ما أوردنا عليه سابقاً من التناقض.
فكلامه(رحمه الله) في غاية التحقيق، ولكن تسليمه الاعتراض بالمصدر المضاف واعتذاره عنه بأنّه ليس بالوضع، كأنّه أجنبيّ عمّا هو التحقيق، ولا ينبغي صدوره من مثله؛ فإنّ «الضرب» له معنى يقع بحذائه، غاية الأمر أنّه قائم بغيره، ولذا يمكن أن يحكم عليه وبه، وأين هو من الحروف الّتي لا يقع بحذائها شيء من المعنى أصلاً، وإنّما يكون ما تفيده فيما بحذاء لفظي الطرفين؟ ومن هنا يكون إرجاع الضمير في قولهم: «الحرف ما دلّ على معنى في غيره» إلى اللفظ أولى من إرجاعه إلى المعنى، لصدقه على التقدير الثاني على ألفاظ الأعراض مع أنّها ليست بحروف، فتدبّر.
إذا عرفت ما ذكرناه، تبيّن لك أنّ ما أفاده المصنّف(قدس سره) في مسألة المشتقّ((1)) من افتراق الإسم والحرف في كيفيّة الإستعمال في المعنى، وهو المراد بما أفاده هنا من كون افتراقهما في الوضع،((2)) في غاية الجودة. ولكن ما ذكره من أنّ ما يستعمل فيه
ص: 30
لفظة «من» هو عين ما يستعمل فيه لفظ الإبتداء،((1)) وهو المعنى الكلّي المجرّد عن جميع الخصوصيّات عند استعمالها فيه وإن كان يتقيّد بعدُ بمداليل الألفاظ الاُخر؛ كأنّه بعيد من الصواب.
انتهى ما كان عندنا من حاشية سيّدنا الاُستاذ(قدس سره) - بإنشائه وقلمه الشريف - على الكفاية.
ص: 31
ص: 32
وقد أفاد سيّدنا الاُستاذ فيما حقّقه في هذا البحث على ما يستفاد من تقريرات بحثه الّتي كتبها بعض الأفاضل من تلامذته)(1)) في بروجرد حاشية على الكفاية.
قوله(قدس سره): «صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع أو بالطبع؟ وجهان، بل قولان ؛ أظهرهما أنّه بالطبع...».
إنّ الاستعمالات المجازية لا تحتاج صحّتها إلى وضع مختصّ بها، بل يكفي فيها وضع الألفاظ لمعانيها الحقيقية واستعمال تلك الألفاظ في غيرها من المعاني المشابهة أو المضادّة أو المناسبة لمعانيها الحقيقية؛ ويكفي في ذلك ملاحة هذا الاستعمال حسبما يدركه و يستحسنه الذوق والطبع المستقيم.((2))
فالتحقيق: أنّ استعمال اللفظ في المعنى المجازي يكون بتوسّط استعماله في المعنى
ص: 33
الحقيقي، لا بأن يستعمل في المعنيين، بل يستعمل المتكلّم اللفظ في الموضوع له مدّعياً اتّحاده مع غير الموضوع له بنفس ذلك الاستعمال ونصب القرينة على أنّ مراده الجدّي غير الموضوع له. فالمتكلّم الّذي يرى ادّعاءً اتّحاد الموضوع له مع غيره، يستعمل اللفظ في الموضوع له، ويفهم ادّعاءه وإرادته الجدّية بنفس استعمال اللفظ ونصب القرينة. فهو يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس المتّحد مع الرجل الشجاع ادّعاءً الّذي هو مراده الجدّي في قوله: رأيت أسداً.((1))
ص: 34
إعلم: أنّه لابدّ للإنسان في إفهام مقاصده لغيره ممّا یدلّ عليها، وليس يوجد فيما یدلّ عليها أسهل وأدلّ من الألفاظ، ولمّا لم تكن بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية بها يختصّ کلّ واحد من الألفاظ بمعنى خاصّ من المعاني حتى ينتقل الذهن منه إليه، احتاج إلى علاقة وضعية يصير بها کلّ لفظ فانياً في معناه، فجعل لکلّ معنى من المعاني لفظاً خاصّاً يفهم به المخاطب مراد المتکلّم. هذا إذا كان المتکلّم مريداً لمعنى من المعاني.
وأمّا إذا كان مراده نفس اللفظ والحكم عليه أو به، فلا حاجة إلى هذه العلاقة الوضعية؛ لأنّه ليس في ذلك دلالة شيءٍ على شيءٍ أو إرادة شيءٍ من شيءٍ أو استعمال شيءٍ في شيءٍ، بل کلّ ما هناك هو إفهام المتكلم مقصده بنفس إيجاد اللفظ ليلتفت ذهن المخاطب إليه.
وهذا اللفظ الّذي يوجده المتکلّم يكون جزئيّاً حقيقيّاً بالنظر إلى وجوده الخاصّ. ومع قطع النظر عن ذلك يكون كليّاً؛ فإن أوجده وأراد به أن يلتفت الغير إلى وجوده الخاصّ، فهو من إيجاد اللفظ وإرادة شخصه، أي إرادة التفات المخاطب إلى شخصه جزئياً.
وإن أوجده مطلقاً لالتفات الغير إليه، فهو من إيجاد اللفظ لأن يلتفت الغير إلى نوعه.
وإن أوجده مقيّداً بقيد زائد يخصّه بصنف خاصّ يريد التفات المخاطب إليه، فهو من إيجاد اللفظ للالتفات إلى صنفه.
ص: 35
وليس ذلك من باب استعمال اللفظ ودلالته على معناه الّذي وضع له اللفظ، حتى يورد على الحكم عليه بشخصه باتّحاد الدالّ والمدلول، أو تركّب القضیّة من جزءين،((1)) فافهم وتدبّر.
ص: 36
إعلم: أنّه قد استقرّ بناء العرف والعقلاء على استخدام الألفاظ لإفهام مراداتهم ومقاصدهم؛ لأنّه ليس فيما يتوسّل به لذلك ما هو أسهل من الألفاظ الجارية على اللسان. ولمّا لم يكن للألفاظ بالذات اختصاص بمعانيها الخاصّة وضعوا لکلّ معنى من المعاني لفظاً خصّ به حتى يكون دليلاً عليه ومرآةً له. والغرض من الوضع وإن كان استخدام هذه الألفاظ عند إرادة تلك المعاني، إلّا أنّ هذا ليس من قيود المعنى، وإلّا يلزم أن لا يكون المعنى حاصلاً في الخارج، ولا يكون اللفظ مرآة لما في الخارج، مثلاً لفظ «إنسان» إذا كان موضوعاً للطبيعة الكلّية الّتي تصدق على أفرادها الخارجية يصدق عليها لا محالة، أمّا إذا كان موضوعاً لها إذا كانت مرادة، فالمعنى بهذا الاعتبار لا يوجد إلّا في الذهن؛ لأنّ ما في الخارج ليس إلّا المعنى وأفراد الإنسان، فلابدّ من استعمال اللفظ في جزء معناه مجازاً حتى يتم به الغرض، أي إفهام المعنى وهو الإنسان الموجود خارجاً بأفراده.
ولا يصحّ أن يكون ذلك من باب الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ؛ إذ أنّ ذلك يصحّ إذا لوحظ معنىً كليٌّ ووضع اللفظ بإزاء کلّ فرد من أفراده، بخلاف ما إذا لوحظ معنىً كلّي مقيّد بقيد لا يتحقّق معه إلّا في الذهن ووضع له اللفظ، فلا يصحّ
ص: 37
استعمال هذا اللفظ في المعنى الخالص من القيد إلّا مجازاً، بل لا يصحّ وضع اللفظ لأفراد ذلك الكلّي خالصاً من هذا القيد، فإنّه من وضع اللفظ لغير ما لوحظ من المعنى. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ هذا ليس إلّا من ملاحظة المعنى الكلّي الخالص من قيد كونه مراداً ووضع اللفظ للمعنى الكلّي أو لأفراده.
وبالجملة: لا يتصوّر لوضع اللفظ للمعنى بما هو مراد المتکلّم فائدة عقلائية، بل إنّ ذلك ينافي حكمة الوضع. هذا مضافاً إلى غير ذلك ممّا يترتّب عليه من المفاسد.
ومن ذلك يعلم: أنّ ما حكي عن المحقّق الطوسي وابن سينا((1)) من أ نّهما ذهبا إلى «كون الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي مرادة» ليس في محلّه، ولا يصحّ أن ينسب إلى مثلهما.
ص: 38
اعلم: أنّ مختار المشهور((1)) في الفرق بين الحقيقة والمجاز: أنّ الحقيقة استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له - أي المعنى الّذي جعل اللفظ مرآة له ومختصاً به - تعييناً أو تعيّناً. وأمّا المجاز فاستعماله في غير ذلك المعنى؛ لوجود علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي - الموضوع له - .
والمختار عندنا:((2)) أنّ المستعمل فيه في الاستعمالين هو المعنى الحقيقي، إلّا أنّ المستعمِل في الأوّل يجعل اللفظ بحذاء المعنى بما هو هو، وفي الثاني يستعمل فيه أيضاً بادّعاء كون مراده الجدّي عين المعنى الموضوع له (أو من أفراده ومصاديقه).
وأمّا إذا تردّد الأمر في أنّه استعمل على النحو الأوّل أو الثاني؟ فالظاهر أنّ ذلك يفهم من ملاحظة كيفية المحاورة ومن تعابيرهم في بيان المقاصد والمرادات.
ويمكن أن يقال: إنّ الأصل بعد ما علم المعنى الموضوع له حمله على الاستعمال في المعنى الحقيقي، إلّا إذا ثبت خلافه بوجه من الوجوه، وإن كان ذلك لصيرورة المعنى
ص: 39
المجازي أشهر أو مساوياً في الاستعمالات مع المعنى الحقيقي، فحينئذٍ يستفاد ذلك من التامّل في المحاورات.
وأمّا إن كان الشكّ في المعنى المراد من جهة الشكّ في المعنى المجازي والحقيقي، لا من جهة أنّ المتکلّم استعمله في المعنى المجازي أو الحقيقي المعلومَين عند الطرفين، حتى يقال: الأصل أو الظاهر استعماله في المعنى لحقيقي، بل الشكّ في أنّه أيّ واحد من المعنيين حقيقيٌّ لكي يحمل اللفظ عليه، وأىّ واحد منهما مجازي حتى لا يحمل عليه؟ فهنا يرجع إلى علائم الحقيقة والمجاز.
فمنها: التبادر
والمعروف أنّه علامة اختصاص اللفظ بالمعنى - تعييناً أو تعيّناً -. وبعبارة اُخرى: تبادر المعنى من اللفظ ودلالته عليه وانسباقه إلى الذهن علامة الحقيقة واختصاص اللفظ بالمعنى.
لكنّ الظاهر أنّ التبادر عين الوضع، لا أنّه علامة عليه؛ إذ هو نفس دلالة اللفظ على المعنى، لأنّ المراد من الوضع ليس خصوص التعييني بل هو أعمّ منه ومن التعيّني، ومعنى الوضع فيهما صيرورة اللفظ دالّا على المعنى بوضع الواضع أو كثرة الاستعمال.((1))
ومنها: عدم صحّة السلب وصحّته، وصحّة الحمل وعدمه عدم صحّة سلب اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن عن المعنى المشكوك فيه علامة الحقيقة، كما أنّ صحّة سلبه عنه كذلك علامة كون اللفظ فيه مجازاً.
ص: 40
وبعبارة اُخرى: صحّة سلبه عن المعنى علامة المجاز، وصحّة حمله عليه علامة الحقيقة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المحمول والمسلوب في القضیّة اللفظ بما له من المعنى أو نفس المعنى، وأمّا الموضوع والمسلوب عنه فلا يكون إلّا المعنى المشكوك فيه.
لا يقال:((1)) إنّ سلب المعنى الحقيقي الواحد أو بعض المعاني الحقيقية أو اللفظ بما له من المعنى الواحد أو الأكثر عن المعنى المشكوك لا یدلّ على عدم كونه المعنى الحقيقي، لاحتمال الاشتراك. كما أنّ سلب جميع المعاني الحقيقية عن المعنى المشكوك لا ينهض دليلاً على مجازيّته، أي لا حاجة إلى هذا الدليل؛ لأنّه مع العلم بجميع المعاني الحقيقية لا يبقى مجال للشكّ.
فإنّه يقال أوّلاً: إنّ ذلك يتمّ في سلب المعاني عنه بالمفهوم، ولكن السلب أعمّ من المفهوم أو المصداق، فتكون صحّته دليلاً على المجازية.
وثانياً: المعنى المسلوب ليس المعلوم كونه حقيقياً حتى يقال: مع هذا العلم لا يبقى مجال للشكّ، بل هو مفهوم مّا للّفظ في ارتكاز أهل المحاورة، فلا علم لنا بجميع المعاني الحقيقية قبل هذا السلب حتى يرد علينا الإشكال المذكور.
ومنها: الاطّراد وعدمه
ولا يخفى أنّ المراد من علامية عدم الاطّراد إن كان بملاحظة نوع العلائق المجازية، فلا ريب في عدم اطّراده، وإن كان بملاحظة صنفها، فلا ريب في اطّراده،((2)) نعم بناءً على مختارنا في الفرق بين الحقيقة والمجاز - وأنّ اللفظ في كليهما يستعمل في معناه الموضوع له، إلّا أنّه في المجاز يجعل المعنى عين المعنى الموضوع له (أو فرده ادّعاءاً) -
ص: 41
تصحّ العلامية؛ إذ لا يطّرد هذا الادّعاء ولا يستحسنه الذوق ولا يستملحه الطبع دائماً، مثلاً استعمال الأسد في الرجل الشجاع يستملح ويوافق الذوق في مقام حكاية رميه ودفعه العدوّ، ولا يستملح في مقام أكله أو غيره من أفعاله العادية، وهذا بخلاف استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، فإنّه مستحسن ومقبول لدى الذوق والطبع في جميع المقامات، فيحسن استعمال زيد مثلاً في معناه في مقام الإخبار عن عمله ومدحه وفي مقام الإخبار عن جسمه وكلّ فعل وحال من أفعاله وأحواله، وهذا المعنى للاطّراد يصحّ أن يكون من علائم الحقيقة وعكسه - عدم الاطّراد - من علائم المجاز.((1))
ص: 42
قد وقع الخلاف بينهم في أنّ المسمّى بأسماء العبادات مثل الصلاة والصوم والحجّ، هو ما كان مصاديقه خصوص الصحيح وما يترتّب عليه الأثر ويقع به الإمتثال، أو أعمّ منه وممّا يقع فاسداً ولا يتحقّق به الإمتثال؟
فلا يتوهم أنّ مرادهم من عنوان البحث - بأنّ ألفاظ العبادات هل هي أسامٍ لخصوص الصحيحة أو أعمّ منها - هو كون مفهوم الصحيح مأخوذاً في المعنى والمسمّى أم لا؟ فإنّ عدم كون ذلك مأخوذاً في تلك الأسامي، معلوم مسلّم عند الجميع.
وقبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على اُمور:
إنّ المراد بالصحّة هو التماميّة، ويعبّر عنها في الفارسية ب- «درستى»؛ وعمّا يوصف بها بالصحيح والتامّ بالعربية، وبالفارسية ب- «درست». ومقابل الصحّة الفساد المعبّر عنه في الفارسية ب- «نادرستى»، كما أنّ مقابل الصحيح الفاسد المعبّر عنه في الفارسية ب- «نادرست».
وهذا التقابل لا يأتي في الأشياء بالنسبة إلى نفس ذواتها فلا يتّصف بالصحّة والفساد الموجود في الخارج، بل ولا المفاهيم بالنسبة إلى ذواتها، بل الاتّصاف بهما
ص: 43
يكون بالنسبة إلى غير ذواتها من العناوين الخارجة عنها، فيوصف الشيء بالصحّة إذا كان مصداقاً لعنوان مّا، وبالفساد إذا لم يكن كذلك.
وبالجملة التقابل بين الصحّة والفساد تقابل العدم والملكة،((1)) ولا يتصوّر في نفس الشيء وذاته بل لابدّ أن يكون بين الشيء وعنوان من العناوين، فهو يتّصف بالصحّة إذا كان مصداقاً لهذا العنوان، ويتّصف بالفساد إذا لم يكن مصداقاً له مع أنّ من شأنه أن يقع مصداقاً له.
وبالجملة: الصحّة والفساد لا يأتيان مثلاً في أفعال الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام بالنسبة إلى ذواتها، أي الحركة المحقّقة في الخارج، فهي لا تتّصف بالفساد؛ لأنّ معنى اتّصافها بالفساد نفي ذاتها عن ذاتها وسلب الشيء عن نفسه، ولذا لا توصف بالصّحة أيضاً؛ لأنّ ما لا يوصف بالفساد لا يوصف بالصّحة، ولكن توصف هذه الحركة الخاصّة بالصحّة بالنسبة إلى عنوان الركوع أو السجود أو القيام، فإذا كانت مصداقاً بالنسبة إلى هذا العنوان تكون صحيحة، وإذا لم تكن مصداقاً له تكون فاسدة.
وممّا ذكر يظهر أنّ الصحّة والفساد وصفان إضافيّان، ولذلك يمكن أن يكون شيء واحد صحيحاً بالنسبة إلى عنوان أو عناوين، وفاسداً بالنسبة إلى عنوان أو عناوين اُخرى.
لا يخفى أنّه لابدّ من تصوير الجامع بين أفراد الصحيح على القول به، وأفراد الأعمّ أيضاً على القول به، إلّا أنّهم وقعوا لذلك في الإشكال. ولا ريب في عدم إمكان تصوير
ص: 44
جامع ذاتي على القولين، لعدم تعقّل الجامع الذاتي بين الاُمور المتباينة بالذات. كيف ولا يعقل ذلك في خصوص ما هو المصداق للصلاة مثلاً، كصلاة الكامل المختار التامّة الشرائط والأجزاء، فلا جامع ذاتي بين هذه الأجزاء والشرائط يختصّ بها دون غيرها؛ فما ظنّك بالجامع الذاتي بين جميع مراتب الصلاة - قصراً وتماماً، ومضطرّاً ومختاراً- .
أمّا الجامع بين مثل أجزاء الصلاة وشرائطها وبين مراتبها وأفرادها فليس إلّا ما يكون عرضياً، سواء كان المختار هو القول بالصحيح أو الأعمّ.
فنقول: أمّا الجامع العرضي بين أفراد الصحيح، فقال في الكفاية: «لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، يؤثّر الكلّ فيه بذاك الجامع، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلاً: بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن، ونحوهما».((1)) انتهى.
ويمكن الإيراد عليه:
أوّلاً: بأنّ الأثر الخاصّ المترتّب على أفراد الصلاة إذا كان مثل النهي عن الفحشاء أو كونها معراج المؤمن، لا يمكن أن يكون هو الجامع بين الأفراد والمسمّى بالصلاة، لأنّه لا يثبت به عدم ترتّبه على غيرها.
وثانياً: بأنّ الظاهر من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْ-مُنْكَرِ﴾،((2)) أنّها حقيقة يكون النهي عن الفحشاء أثرها، ولو كان معنى الصلاة هو الناهية عن الفحشاء يصير المعنى: الناهية عن الفحشاء تنهى عن الفحشاء، وهو المصادرة على المطلوب، وهذا لا يليق بالقرآن الكريم.
ص: 45
فالصحيح أن يقال بأنّ ما هو الجامع العرضي بين أفراد الصلاة هو ما لا يتحقّق في ضمن غيرها مثل: غاية الخضوع وكمال العبودية والتوجه الخاصّ الّذي يتحقّق في ضمن أفرادها المختلفة الأجزاء والشرائط بحسب الحالات، حتى وإن لم نعلم به تفصيلاً إلّا أ نّنا نعلم بوجوده في الجملة، فإذا دلّ الدليل على أنّ المسمّى باسم الصلاة أو الصوم أو غيرهما هو الصحيح نأخذ به، ونقول بالقدر الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة أو الصوم الصحيح.
وقد يشكل: بأنّ الجامع الّذي لم نتحصّله بعنوان لا يمكن أن يكون أمراً مركّباً؛ إذ کلّ ما فرض جامعاً يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً. كما لا يمكن أن يكون أمراً بسيطاً؛ لأنّه إمّا أن يكون مثل عنوان المطلوب، أو ملزوم المطلوب المساوي له، والأوّل مستلزم للدور لتوقّف تحقّق هذا العنوان على الطلب وتوقّف الطلب عليه. مضافاً إلى أنّه جامع عامّ يشمل جميع أفراد العبادات. ومضافاً إلى أنّ ذلك مانع من إجراء البراءة في أجزاء العبادات وشرائطها، لعدم الإجمال حينئذٍ في المأموربه وإنّما الإجمال فيما يتحقّق به وفي مثله لا مجال لها، كما حقّق في محلّه، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشكّ فيهما.
وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضاً، فلا تجري البراءة معه.
وأجاب في الكفاية عن هذا الإشكال: «بأنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المرکّبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات، متّحد معها نحو اتّحاد، وفي مثله تجري البراءة، وإنّما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجياً مسبّباً عن مركّب مردّد بين الأقلّ والأكثر، كالطهارة المسبّبة عن الغسل والوضوء فيما إذا شكّ في أجزائهما».((1))
ص: 46
وتوضيحه: أنّ مفهوم الصلاة ليس عنوان المطلوب ولا عناوين الأجزاء بذواتها، بل يكون عنواناً عرضياً صادقاً على کلّ الأجزاء الأصلية تارة، وعلى البعض اُخرى، وعلى أبدالها ثالثة، مع وجود جميع الشروط في الجملة تارة ومع عدمها اُخرى، وهكذا في الموانع.
وهذا العنوان العرضي لمّا كان صادقاً على الأجزاء بالفعل متّحداً معها في الخارج، كان وجوده عين وجودها، فكان بحسب الوجود مركّباً وإن كان بحسب المفهوم بسيطاً، فإذا شكّ في جزئية شيءٍ شكّ في نفس متعلّق الوجوب، فينحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالوجوب والشكّ البدويّ فيه، فتجري البراءة النقلية على مختاره، والعقلية أيضاً على مختارنا تبعاً للقوم. وإنّما لا تجري البراءة فيما إذا كان البسيط المعلوم مسبّباً عن المرکّب، فإنّ وجوده غير صادق عليه.
ويمكن الإشكال بأنّه وإن شيّدنا أركان القول بجريان البراءة العقلية عند الشكّ في الجزئية والشرطية ودفعنا ما أورده شيخنا(قدس سره)، لكن جريان البراءة فيما إذا كان المكلّف به مفهوماً منتزعاً من جملة وجودات باعتبار الإضافة إلى شيءٍ آخر إمّا بالعلّية أو بغيرها وشكّ في مدخليّة وجود في انتزاع هذا المفهوم وتحقّق هذه الإضافة في نفس الأمر عند عدم هذا الوجود، في غاية الإشكال، وإن كان هذا المفهوم متّحداً معها حين ما يصدق، وصادق عليها حين يتحقّق، ألا ترى أنّه إذا أمر المولى عبده بإزهاق روح حيوان وهو يتحقّق منه بجملة اُمور شكّ في دخل واحد، فلم يوجده ولم يتحقّق الإزهاق لم يعدّ معذوراً وإن كان الإزهاق حين تحقّقه صادقاً على نفس هذه الجملة، وهكذا عنوان التعظيم إذا تحقّق بجملة اُمور صادق عليها وشكّ في دخل شيءٍ - جزءاً أو شرطاً-، وتمام الكلام في محلّه.((1))
ص: 47
ص: 48
هذا كلّه في تصوير القدر الجامع على القول بالصحيح. وأمّا على القول بالأعمّ فقد ذكر لتصويره في الكفاية وجوهاً:
أحدها: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلاً، وكان الزائد عليها معتبراً في المأموربه لا في المسمّى.((1))
وأجاب عنه أوّلاً: بأنّ التسمية بها لا تدور مدارها، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان.
وثانياً: بعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمّي.
وثالثاً: بلزوم أن يكون الإستعمال فيما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازاً عنده، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ، لا من باب إطلاق الكلّي على الفرد، ولا يلتزم به القائل بالأعمّ، فافهم.
ص: 49
ثانيها: أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء الّتي تدور مدارها التسمية عرفاً، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمّى، وعدم صدقه عن عدمه.
وأجاب عنه أوّلاً: بما أورد على الأوّل أخيراً.
وثانياً: بأنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى، فيكون شيءٌ واحدٌ داخلاً فيه تارةً وخارجاً عنه اُخرى، بل مردّداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره وذلك عند اجتماع تمام الأجزاء، وهو كما ترى، سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.
أقول: إنّ مراد القائل بهذا الوجه إن كان مفهوم الأجزاء أو مفهوم معظم الأجزاء أو مفهوم أجزاء المطلوب بأمر «أقيموا الصلاة» أو الصحيح من الصلاة، فلا تتحصّل هذه المفاهيم إلّا بتحصّل مفهوم الصلاة، فإذا كان تحصّل مفهوم الصلاة متوقّفاً على تحصّل هذه المفاهيم يدور.
وإن كان مراده مصداق معظم الأجزاء، فمصاديقه كثيرة فلابدّ من تعدّد الوضع أو الوضع لواحدٍ منها، وهو غير الجامع بين الأفراد.
ثالثها: أن يكون وضع الصلاة كوضع الأعلام الشخصية، فكما لا يضرّ في التسمية فيها تبادل الحالات من الصغر والكبر، ونقص بعض الأجزاء وزيادتها، كذلك في الصلاة وسائر العبادات لا يضرّ بالتسمية اختلاف أفرادها حسب تبادل الحالات.
والجواب عنه: بالفرق بين ما نحن فيه وبين الأعلام الشخصية، فإنّ تلك الأعلام موضوعة للأشخاص، مثلاً لفظ «زيد» موضوع لابن عمرو، والموضوع له ليس جسم زيد وبدنه المرکّب حتى يكون اختلافه بحسب الزيادة والنقيصة موجباً لاختلاف معناه، بل الموضوع له يكون أمراً واحداً، وهو ابن عمرو الّذي هو فردٌ معيّنٌ للإنسان، وهو محفوظ في جميع الحالات الطارئة عليه، وهذا بخلاف الحقائق المرکّبة، فإنّ كلّ فردٍ منها موجودٌ بوجودٍ خاصّ تصدق عليه الحقيقة الّتي هو تحتها، وهي الجامعة بين أفرادها.
ص: 50
وبعبارة اُخرى: الموضوع له فيما يكون هو الجامع للأفراد كلّي ينطبق على أفراده لا تصوير له على القول بالأعمّ، بخلاف ما هو الموضوع له في الأعلام الشخصية، فإنّها موضوعة لها، وتشخّص كلّ فردٍ منها بوجوده الخاصّ الباقي ما بقي وجوده.
بل يمكن أن يقال: إنّ الأعلام الشخصية أيضاً وضعها كأسماء الأنواع، فهي أيضاً موضوعة للشخص الإنساني الّذي ينطبق عليه إذا كان واجداً لجميع الأعضاء والأجزاء، وكذا إذا كان فاقداً لبعضها، لكن ذلك لا يكون مصحّحاً لتصوير الجامع على القول بالأعمّ، بل يؤيّد ما ذكرناه في تصويره على القول بالصحيح، لأنّ تصويره على القول بالأعمّ يحتاج إلى جزء خارجي للعبادة يكون باقياً مع انتفاء غيره ممّا له دخل في صحّتها - جزءً أو شرطاً -، فتدبّر.
رابعها: ما ذكره أيضاً في الكفاية وردّ عليه.((1))
ويرد عليه مضافاً إلى ما أورده شيخنا الاُستاذ(قدس سره): أنّ استعمال اللفظ الّذي وضع للصحيح في ما وضع له وإرادة الفاسد منه وغير ما هو الموضوع له منه بدعوى كون
ص: 51
الفاسد هو هو أو فرداً منه، لا يجعل الموضوع له الأعمّ وحقيقة فيه ولا يحدث بذلك جامعاً بين الصحيح والفاسد. غاية الأمر لو استعمل اللفظ في الفاسد وفي غير الموضوع له حتى صار حقيقةً فيه، يصير اللفظ به مشتركاً لفظياً بين المعنيين اللذين لا جامع بينهما.
نعم، يمكن تصوير الجامع بين أفراد الفاسد بأنّه ما لا يترتّب عليه أثر الصحيح.
خامسها: أيضاً ما ذكره في الكفاية وأجاب عنه.((1))
أقول: إنّ الكميّة في أسامي المقادير والأوزان ملحوظةٌ في معاني ألفاظها، لكن يمكن أن لا تكون ملحوظة على نحو لا تشمل الأقلّ منه أو الأكثر بما يتسامح العرف فيه، بل كانت ملحوظة كذلك أي على نحوٍ تشمل الأقلّ منه أو الأكثر في الجملة؛ وليس الأمر كذلك في العبادات، إذ ليست الكميّات المتّصلة أو المنفصلة مأخوذةً فيها حتى يقال بوضع الألفاظ لها، ولا ينافي ذلك أن يعرضها العدد ببعض الاعتبارات.
ذكروا((2)) أنّ ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمّي هو: الرجوع إلى البراءة على الأعمّ، وإلى الاشتغال على الصحيح، وذلك بناءً على التفصيل في مسألة البراءة
ص: 52
والاشتغال بين ما إذا كان منشأ الشكّ - في مدخلية شيء من الجزء أو الشرط في المأمور به - إجمال النصّ، فالمرجع الاحتياط، أو عدم النصّ، فالمرجع البراءة، وذلك لأنّه إذا حصل الشكّ في دخل شيء في المأمور به فعلى القول بالصحيح يكون الشكّ في المسمّى، فيصير الخطاب مجملاً، وعلى القول بالأعمّ يكون الشكّ في الزائد على المسمّى لا لإجمال الخطاب، بل لفقد النصّ الدالّ على اعتبار المشكوك فيه.
وأمّا لو قلنا بعدم الفرق - في إجراء البراءة في الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة - بين إجمال النصّ وفقده، فلا يكون ذلك ثمرة للنزاع، لأنّ البراءة تكون هي المرجع على كلا القولين.
والصحيح أنّه لا وجه للرجوع إلى الأصل في صورة وجود الدليل مثل الإطلاق أو العموم، وهنا - على القول بالأعمّ - المرجع هو إطلاق الدليل وصدق الصلاة على الفاقد للمشكوك جزئيّته فيه أو شرطيته له، فإنّه أحد أفراد المأمور به ومصاديقه. نعم، هذا يكون بعد توفّر شرائط التمسّك بالإطلاق؛ وأمّا على القول بالصحيح فلا مجال للتمسّك بالإطلاق، ولابدّ من الرجوع إلى الاحتياط. اللّهمّ إلّا أن نقول برجوع ذلك إلى الشكّ في الزائد ببيان أسلفناه في طيّ تصوير الوجوب الضمني للأجزاء.
فتلخّص ممّا ذكر: عدم الثمرة للنزاع في الصحيح والأعمّ بالقول بإجراء البراءة أو التمسّك بالإطلاق على القول بالأعمّ، والرجوع إلى الاحتياط على القول بالصحيح، وذلك لما قد ظهر لك من جريان البراءة على القول بالصحيح أيضاً.
المختار في المسألة:((1)) والحقّ الّذي يؤدي إليه النظر في بيان المختار هو: أنّ ألفاظ العبادات كلّها مستعملة في لسان الشرع فيما هو الموضوع له من أوّل الأمر في العصور الجاهلية وما قبلها بل من بدو تكوّن الإنسان، كما تدلّ عليه الآيات والأخبار على أنّ هذه الماهيّات
ص: 53
العبادية ليست من مخترعات الشريعة الإسلامية، بل هي مرسومةٌ ومعمولٌ بها بين أبناء نوع الإنسان من أوائل التاريخ بل من قبل التاريخ،((1)) إلّا أنّها تختلف صورها باختلاف الأدوار والأكوار.
والخصوصيات المجعولة المستحدثة في زمن الإسلام إنّما هي الخصوصيات الفردية المذكورة في لسان الشارع لا ترتبط بالوضع أو الاستعمال المجازي، بل هي مستفادة بالقرينة من باب تعدّد الدالّ والمدلول، كما بنى عليه الباقلاني.((2))
وهذا الّذي قلناه ثابت في تمام الماهيات العبادية من الصوم والصلاة والحجّ والزكاة وغيرها من العبادات، ولذلك قد أنكرنا الحقائق الشرعية أو المتشرعيّة. فالموضوع له هو الحقيقة الّتي وضعت لها هذه الألفاظ من أوّل الأمر، ومعلوم أنّ معانيها أعمّ من الأفراد الموجودة في العصور الجاهلية أو الأفراد الصحيحة الّتي أمر بها الشارع، وهذا يكفي في إثبات القول بالأعمّ، فلا نحتاج في إثبات الأعمّ إلى غير ما أسلفناه في الحقيقة الشرعية.((3))
ونتيجة ذلك: أنّ المرجع فيما شكّ في جزئيّته أو شرطيته في العبادات هو أصالة البراءة؛ لأنّ الشكّ فيه شكّ في وجود الدليل على دخل المشكوك فيه في المأمور به - شرطاً أو شطراً - . وأمّا الإطلاقات فليست في مقام بيان ما هو من مصاديق الصلاة مثلاً في شرع الإسلام حتى يتمسّك بها، وإنّما هي تشير إلى المعنى المركوز في الأذهان - بحسب العرف واللغة - الصادق على أفراده المختلفة حسب المقرّر في الشرائع السابقة وحسب ما يقرّر أو قرّر وبيّن في شرعنا الخالد. إذن فليس هنا إلّا البراءة عمّا نشك في دخله في الصلاة وغيرها، والله هو العالم.
ص: 54
ثم إنّه قد استدلّ للقائل بالصحيح بوجوه:((1))
منها: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار، للصلاة مثلاً ، كقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «الصلاة عمود الدين»،((2)) أو «الصوم جُنّةٌ من النار»،((3)) فإنّ هذه الخواص لا تترتب إلّا على الصحيح منها.
وكذا: ما یدلّ من الأخبار على نفي ماهيتها وحقيقتها لفقد بعض شرائطها أو أجزائها، كقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»،((4)) ولو كان الموضوع له هو الأعمّ لا يصحّ نفي الحقيقة لمجرد ذلك.
وفيه:((5)) أنّ التمسّك بمثل أصالة العموم أو أصالة الحقيقة إنّما يصحّ إذا كان الشكّ واقعاً في مراد المتکلّم، وأ نّه أراد العموم أو أراد الحقيقة أم لا؟ أمّا إذا شككنا في كيفية إرادته مع العلم بمراده فلا يتمسّك بالاُصول اللفظية؛ وفي المقام نعلم أنّ مراده(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)
ص: 55
من الصلاة الّتي هي عمود الدين الصلاة الصحيحة، ونتردّد في كيفية الاستعمال المذكور فهل هو حقيقي أو مجازي؟ فإذا قال المولى: أكرم العلماء وقال: لا تكرم زيداً، يدور الأمر بين كون خروج زيد عن تحت عنوان «العلماء» العامّ، تخصيصاً أو تخصّصاً، بعدم وجوب إكرام زيد لا يصحّ التمسّك بأصالة العموم لإثبات خروج زيد عن تحت العامّ بالتخصيص، كما لا يجوز التمسّك بأصالة العموم إذا شككنا في كون زيد أو عمرو عالماً، لكونه من التمسّك بعموم العامّ في الشبهة المصداقيه.
وهكذا نقول في مثل قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»، فتدبّر.
ثم إنّه قد استدلّ للأعمّي بوجوه:((1))
منها: صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في المكان المكروه فيه الصلاة كالحمّام لمرجوحيتها، فلو كان ما وضع له لفظ «الصلاة» خصوص الصحيح، يكون متعلّق النذر هو ترك الصلاة الصحيحة، وهي بعد تعلّق النذر بتركها لا يمكن أن تقع صحيحة، فلا موقع لتركها في المكان المنذور تركها فيه وفاءً بالنذر بل مطلقاً، لانتفاء متعلّق الترك المنذور لوقوعه فاسداً لا صحيحاً، فلا يتحقّق به الحنث، وما يتحقّق به الحنث لا يمكن تحقّقه لحرمته ولوقوع الحنث المحرم به، فيلزم من تعلّق النذر بترك الصلاة الصحيحة عدم ما يمكن أن يكون صحيحاً حتى يتعلّق الترك المنذور به، فيلزم من وجوده عدمه.
وفيه: أنّ هذا الإشكال يأتي على القول بالأعمّ أيضاً، لأنّ متعلّق النذر إن كان فعلاً من الأفعال يجب أن يكون راجحاً، وإن كان ترك فعل من الأفعال يجب أن يكون ذاك الفعل مرجوحاً، وما هو المرجوح في المكان المكروه فيه الصلاة كالحمّام هو الصلاة
ص: 56
الصحيحة سواء كان الموضوع له الصحيح أو أعمّ. ولا يصحّ أن يكون متعلّق النذر ترك الصلاة الفاسدة أو أعمّ منها، لما ذكرنا من اشتراط كون الفعل الّذي تعلّق النذر بتركه مرجوحاً، إذن فلا فرق في تأتّي الإشكال بين القولين.
والجواب عن أصل الإشكال: عدم صحّة النذر في المقام بأن يقال: إنّ المصحّح للنذر - إذا تعلّق بترك فعل - إنّما هو مرجوحيته ذاتاً لا بالإضافة إلى سائر أفراده العرضية، كالصلاة في الحمّام، فإنّها مرجوحة بالنسبة إلى الصلاة في البيت أو في المسجد لا بملاحظة ذاتها بل بملاحظة كون غيرها أفضل وأكثر ثواباً منها، فلا يتعلّق بتركها النذر بل يتعلّق بفعلها النذر، إلّا أن يرجع النذر في الأوّل إلى إتيان الصلاة في البيت أو في المسجد، فلا يجوز إتيانها في الحمّام لوقوعها عصياناً للأمر بإيقاعها في المسجد، وفي الثاني يرجع إلى ترك الصلاة في المسجد وفي البيت، فتدبّر.((1))
الأوّل: هل يجري النزاع المذكور في العبادات، في المعاملات أيضاً أو لا؟
ذهب المحقّق الخراساني إلى التفصيل بين القول بكون أسامي المعاملات موضوعة للمسبّبات، فقال: لا مجال للنزاع في كونها للصحيحة أو للأعمّ؛ لعدم اتّصافها بهما، وبين كونها موضوعة للأسباب.((2)) فلم يمانع من جريانه.
وتوضيحه: أنّ لکلّ قسم من المعاملات معنى إعتبارياً ليس له وجود إلّا في عالم الاعتبار، فلا وجود له حقيقیاً سوى منشأ انتزاع هذا الاعتبار الّذي هو كالعلّة بالنسبة إليه، فإذا تحقّق ذلك المنشأ وجد هذا العنوان الاعتباري في عالم الاعتبار، وإذا اختلّت بعض شرائطه فلا يتحقّق.
ص: 57
وبعبارة اُخرى: أمر هذا الأمر الاعتباري دائرٌ بين الوجود والعدم، ووجوده يدور مدار وجود علّته، فلا يتّصف بالصحّة تارةً وبالفساد اُخرى، بل يتّصف بالوجود أو بالعدم. وعليه فإن كانت الأسماء موضوعة لهذا المعنى الاعتباري - المسبّب - فلا مجال للنزاع.
أمّا إذا كانت تلك الأسامي موضوعة للأسباب (وإن شئت قلت: مستعملة في الأسباب) فيمكن وقوع النزاع فيها، ويقال: إنّ عنواناً، مثل البيع، هل هو موضوع للعقد الجامع لشرائط التأثير في ملكية الثمن والمثمن للمشتري والبائع، أو موضوع لأعمّ منه ومن غير المؤثّر؟
ولا يبعد دعوى كونه موضوعاً لما هو الصحيح والمؤثّر.
هذا بيان لما أفاده شيخنا الاُستاذ(قدس سره)، لکنّه تفصيل لا يخلو عن الإشكال، وذلك لأنّ أسامي المعاملات، مثل البيع والإجارة، إنّما تكون موضوعة لماهيّاتها من غير تحيّثها بحيثية الوجود والعدم، فالماهيّات وإن كانت تارة موجودة في الخارج واُخرى غير موجودة، لكنّ الموضوع له هو نفس ماهيّة الملكية ونفس ماهيّة (عُلقة) الزوجيّة وغيرهما، فلا يصحّ التفصيل المذكور.
والدليل على ذلك صحّة إطلاق المعدوم عليها، فيقال: البيع معدوم، ولو كان البيع موضوعاً للمسبب الموجود والماهية الموجودة، يلزم التناقض بحمل المعدوم عليه. وكذلك يقال: البيع موجود، فلو كان معناه الماهيّة الموجودة يكون معناه: الّذي هو موجود موجود. فما ذكره(قدس سره) وجهاً للتفصيل غير وجيه، لأنّ السببیّة والمسبّبيّة من لوازم الوجود لا الماهية، وقد عرفت أنّ أسامي المعاملات موضوعة للمعاني المعرّاة عن الوجود، أي الماهيّات.
نعم، الألفاظ المشتقّة من هذه الأسامي، كلفظ «باع» و«يبيع» و«بع» الموضوعة للإخبار والأمر، تدلّ على وجود مصاديقها أو طلب إيجادها.
ص: 58
وعلى هذا، فالحقّ عدم تأتّي الخلاف في أسماء المعاملات مطلقاً من غير تفصيل بين الأسباب والمسبّبات.
الأمر الثاني: أفاد في الكفاية:((1)) كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها، بناءً على تعلّق الأحكام بالأفراد، كما توهّم في ألفاظ العبادات.
لأنّ إطلاقها - لو كان في مقام البيان - يشمل کلّ ما هو فردٌ لها عند العرف، فلو كان يعتبر في البيع مثلاً شيئاً زائداً على ما هو المعتبر عند العرف لكان على المولى أن يبيّنه. نعم، لو شكّ في اعتبار أمرٍ فيه عند العرف لا يصحّ التمسّك بالإطلاق، كما أنّه لا يتمسّك بالإطلاق إلّا مع وجود ما يسمّونه بمقدّمات الحكمة الّتي هي عند صاحب الكفاية الاُمور الثلاثة المذكورة في محلّها.((2))
وأمّا بناءً على تعلّق الأحكام بالطبائع، كما هو الحقّ، فيشكل التمسّك بالإطلاق لإثبات عدم مدخلية المشكوك دخله؛ لأنّ الشكّ في اعتبار شيءٍ، في فردية عقدٍ معيّنٍ لطبيعة البيع مثلاً، شكّ في كونه مصداقاً لتلك الطبيعة، والتمسّك بالإطلاق لإثبات ذلك تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيه.
نعم، إذا رجع ذلك إلى الشكّ في دخل جهة زائدة على نفس الطبيعة صحّ التمسّك بالإطلاق لنفيها.
وربما يقال: إنّ الطبيعة إذا كانت معلومة عند العرف، لا يكون الشكّ في فردية شيءٍ لها إلّا بالشكّ في مدخلية حيثيةٍ زائدة على ما هي حيثيتها عند العرف، فيتمسّك لعدم دخلها بالإطلاق، فتأمّل.((3))
ص: 59
الأمر الثالث: في تحقيق معنى الجزء، والشرط، والفرق بينهما، فنقول: إنّ دخل شيءٍ في تحقّق المأمور به إمّا يكون بتركّب المأمور به منه ومن غيره، ويكون ممّا به قوام ذاته وماهيته كالركوع والسجود وغيرهما من أجزاء الصلاة، فهذا جزؤه وما به قوام ماهيته وحقيقته؛ وإمّا يكون شيئاً خارجاً عن حقيقة المأمور به وما يتركّب منه، لكن له دخلٌ في تحقّقه أو تحقّق أجزائه، فهو من مقدّماته ويسمّى شرطه، كمقدّمات الصلاة، مثل الطهارة وغيرها ممّا تتوقّف الصلاة عليه وتكون مشروطة بوجوده قبلها أو بعدها أو حين أدائها.
فالأمر الوجودي الّذي يكون مع غيره تكويناً أو تشريعاً - ويعدّ بالاعتبار شيئاً واحدا ً- هو جزء ذلك الشيء؛ والأمر الوجودي الذي يكون وجود المأمور به وتحقّقه متوقّفاً على وجوده - قبله أو بعده أو مقارناً له - هو شرط المأمور به.
وبعبارة اُخرى: يكون المأمور به مقيّداً بذلك الشيء ولا يتحقّق بدونه، بنحوٍ يكون التقيّد داخلاً في المأمور به، والقيد كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة خارجاً عنه. وهذا معنى كون الطهارة من شرائط الصلاة.
وأمّا ما يستفاد من الكفاية((1)) من دخل شيءٍ عدميّ في المأمور به واعتباره شرطاً أو شطراً، ففيه: أنّ العدم لا يؤثّر ولا يوصف بالتأثير والتأثّر. وعدّهم «عدم المانع» من أجزاء العلّة التامّة، يكون من المسامحة في التعبير، والمراد: أنّ وجود المانع، كالقهقهة، يكون مخلّا، لا أنّ عدمه مؤثّرٌ في وجود المأمور به - شطراً أو شرطاً- .
وبالجملة: المأمور به ليس إلّا المشروط والمقيّد بقيدٍ كذائيّ وجوديّ الّذي يكون لوجود القيد دخل في وجوده لتقيّد وجوده به، وأمّا عدم المانع فلا يؤثّر في وجوده. نعم،
ص: 60
وجوده يكون في ظرف عدم مانعه، لا أنّ عدم مانعه يكون مقدّمة لوجوده. ومعنى اعتبار عدم المانع: وجوب إزالة المانع، وفرقٌ بين كون وجود شيءٍ مانعاً عن وجود آخر، وبين كون عدمه شرطاً لوجوده، وما لا يعقل تصوّره هو الثاني. وكيف كان، فالمعاني معلومة خارجاً سواء كانت التعابير عنها مطابقةً للإصطلاح، أو مخالفةً له.
ص: 61
ص: 62
وقبل الخوض والكلام فيه، ينبغي بيان مقدّمات:
مبحث هنا: في بيان معنى المشتقّ الّذي يمكن أن يقع فيه النزاع، وبيان الفرق بينه وبين ما لا يمكن أن يقع النزاع فيه؛ فنقول: إنّ المفاهيم المنتزعة على أقسام:
منها: ما يكون منتزعاً من مقام الذات مع الإغماض عن اللواحق الخارجة عنها، بحيث إذا فُرضت الذات بما هي هي مجرّدةً عن کلّ قيد، ينطبق عليها هذا المفهوم، وتكون الذات مصداقاً له حين فرض خلوّها عن جميع اللواحق.
والوجه في ذلك: أنّ المفهوم لا ينتزع إلّا من مرتبة الذات، فلابدّ وأن يكون في مرتبة الذات منطبقاً عليها بلا تأخّر عنها ولا تقدّم عليها، ويقال لهذا: الذاتي.
ومنها: ما ينتزع من المرتبة المتأخرة عن الذات وهو: ما يسمّونه في المنطق «بالعرض» أي ما يكون خارجاً عن الذات. وينقسم إلى قسمين: اللازم، والمفارق.
فالعوارض اللازمة لا تفارق الذات مادامت الذات موجودة وباقية.
والعوارض المفارقة تجري على الذات تارة ولا تجري عليها تارة اُخرى، كالضحك والقيام والقعود وغيرها.
ص: 63
ولا يخفى عليك: أنّ النزاع في مسألة المشتقّ إنّما يكون في هذا القسم الأخير. والظاهر كون أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة وصيغ المبالغة من هذا القبيل.((1))
لابدّ في المفاهيم المفارقة الصادقة على الذات من وجود حيثية الصدق ومناط صحّة حمل المفهوم عليها حتى يكون صدق مفهوم على ذاتٍ دون غيرها نتيجة لوجود تلك الحيثية فيها دون غيرها، فمفهوم الضارب أو الشارب مثلاً لا يصدق على زيد إلّا إذا كانت له خصوصية يصدق عليه بملاحظة تلك الخصوصية أنّه ضارب أو شارب، وهي: خصوصية صدور الضرب عنه مثلاً، فلا يصدق عليه الضارب قبل وجود تلك الخصوصية وإلّا فلو لم تلاحظ هذه الحيثية في حمل المفاهيم المفارقة على الذوات، فلازم ذلك الترجيح بلا مرجّح حين حملها على الذوات في وقت دون الآخر، وحين حمل أحد المفاهيم على إحدى الذوات دون غيرها. فلو فرض عدم تحقّق هذا الملاك في مورد، كما إذا لم يتلبس زيد بالنصر مثلاً في جميع الأزمنة، لا يصدق عليه مفهوم الناصر، وإلّا يلزم من صدقه الترجيح بلا مرجّح، أو صدق کلّ عنوان على کلّ شيء.
المفاهيم الصادقة على الذوات - الّتي فيها ملاك الحمل ومناط الصدق - تنقسم إلى قسمين:
قسم: يكون بإزائه في الخارج شيء، وقسم: لا يكون بإزائه في الخارج شيء، كالرقّيّة والاُبوّة والبنوّة وغيرها من الاُمور الاعتبارية الّتي تنتزع ممّا يكون وعاؤه عالم العين
ص: 64
والخارج، لما فيه حالة أو هيأة أو نسبة له مع غيره، فلا يكون بإزاء هذا القسم من المفاهيم في عالم الخارج شيء غير وجود منشأ إنتزاعه.
وهذه المفاهيم أيضاً على قسمين:
قسم: يكفي فيه تلبّس الذات بالمبدأ آناً مّا ومجرّد حدوث المبدأ في الذات لاعتباره وإنتزاعه، كالاُبوّة والبنوّة، ولا يحتاج صدق المفهوم على الذات - في هذا القسم - إلى بقاء المبدأ وما هو ملاك الحمل وحيثية الصدق؛ إذ بمجرّد حدوث الإبن ينتزع معنى الاُبوّة والبنوّة، فيصحّ حمل مفهوم الاُبوّة على الأب ولو كان ذلك بعد موت الإبن، وبالعكس.
وقسم: لا يكفي فيه مجرّد الحدوث، بل يكون الانتزاع والاعتبار دائراً مدار بقاء المبدأ، فبقاء صدق المفهوم منوطٌ ببقاء المنتزع منه لا مجرّد حدوثه، كانتزاع الفوقية والتحتية من شيئين إذا كان أحدهما أعلى من الآخر.
المراد بالحال في عنوان المسألة،((1)) ليس الحال المذكور في الفعل - الّذي هو أحد الأزمنة الثلاثة - فلا ينبغي توهّم كون النزاع في أنّ مفهوم المشتقّ مقيّد بزمان الحال أو أنّه أعمّ من ذلك، بل مرادهم بالحال حال النسبة والجري.
نعم، حيث إنّ النسبة واقعةٌ في زمانٍ تكون زمانيةً لا محالة، فمفهوم المشتقّ كما لا يكون مقيّداً بمكانٍ لا يكون مقيّداً بزمانٍ أيضاً؛ فالمكان والزمان بالنسبة إلى مفهوم المشتقّ على حدّ سواء.
ص: 65
المراد بالأعمّ ليس الأعمّ المذكور في المنطق الّذي هو في مقابل الأخصّ ويكون أكثر أفراداً من الأخصّ، كالحيوان في قبال الإنسان، بل المراد منه هنا أطولية زمان صدق المفهوم على المصداق، فالمصداق على كلا القولين واحدٌ إلّا أنّه على القول بالأخصّ يكون عمره أقصر من المصداق الّذي يفرض على القول بالأعمّ.
وبعبارة اُخرى: زمان صدق المفهوم على الذات يكون أطول على القول بالأعمّ من زمان صدقه على القول بالأخصّ.
***
إذا عرفت هذه المقدّمات فاعلم: أنّ محلّ النزاع في المشتقّ، وما به يرجع روح الاختلاف في المقام، هو: أنّ المشتقّات الجارية على الذوات هل تكون حقيقة في المتلبّسة بالمبادئ في الحال، أو فيما يعمّها وما انقضت عنها؟ بعد الاتّفاق على مجازيّتها فيما إذا استُعملت واُريد بها من يتلبّس بالمبدأ في الاستقبال.
وبعبارة اُخرى: هل الضارب والشارب وأمثالهما من الأعراض المفارقة تصدق على من كان متلبّساً بالضرب أو الشرب في حال النسبة وجري المفهوم على الذات، أو تصدق على من تلبّس بالمبدأ ولو لم يكن في حال النسبة والجري متلبّساً بالمبدأ؟ بمعنى أنّ من انقضى عنه المبدأ يكون باقياً على مصداقيته للضارب والشارب ببقاء ذاته، لا أنّه في حال التلبّس يكون مصداقاً لهما وفي حال الإنقضاء لا يكون كذلك.
والحاصل: أنّ حقيقة النزاع راجعة إلى أنّ هذا الفرد الّذي صدق عليه مفهوم في زمان مّا، من جهة تلبّسه بالمبدأ في ذلك الزمان، هل يكون باقياً على حاله ومصداقيته لذلك المفهوم بعد انقضاء المبدأ أم لا؟
ص: 66
لا يخفى عليك: أنّ النزاع في المقام: إمّا أن يكون عقلياً بمعنى أنّه هل يصدق عقلاً مفهوم الضارب والناصر وغيرهما على من تلبّس بمبدئهما في الزمان الماضي كما يصدق عليه في زمان التلبّس، أو أنّه لا تصدق عليه تلك المفاهيم إلّا في حال التلبّس بالمبدأ فحسب؟
وإمّا أن يكون النزاع لغوياً، بمعنى أنّ الموضوع له في أسماء الفاعلين وغيرها هل هو المتلبّس بالمبدأ في الحال، أو أعمّ منه وممّن انقضى عنه المبدأ؟
فإن كان النزاع عقلياً: فالقول بالأعمّ ضعيف، يظهر وجهه بالمراجعة إلى المقدّمات المذكورة؛ لأنّه بعد العلم بأنّ حيثية صدق الضارب أو القاعد وملاك الحمل في أمثالهما من المفاهيم الجارية على الذوات ليست إلّا تلبّس الذات بالمبدأ واتّحاده معها، يحكم العقل بعدم صدق تلك المفاهيم بعد زوال حيثية الصدق ومناط الحمل على من كان متلبساً بالمبدأ في الزمان الماضي. فكما أنّه لا يصدق مفهوم من هذه المفاهيم على ذات قبل أن تتلبّس به لكون الذات فاقدة لما هو مناط الصدق، كذلك لا يصدق عليها أيضاً بعد انقضاء زمن التلبّس؛ وذلك لعدم
الفرق بين ما قبل زمان التلبّس وما بعده.
نعم، إذا كان تلبّس مّا كافياً في اعتبار المفهوم وصدقه على الذات، كما أشرنا إليه في المقدّمة الثالثة، فلا مانع من حمل المفهوم على الذوات بعد انقضاء تلبّس الذات بالمبدأ؛ لأنّ ملاك صدق المفاهيم الّتي تكون من هذا القبيل ليس إلّا الأمر الاعتباري الّذي ينتزع من تلبّس الذات بالمبدأ، وهو موجود في عالم الاعتبار، ولا يلزم لاعتبار المفهوم شيءٌ أزيد من حدّوث المبدأ. فعلى هذا ولو كان منشأ الانتزاع متصرّماً لكن ملاك الصدق - وهو الاعتبار - موجود في عالم الاعتبار حتى بعد انقضاء منشأ الانتزاع.
ص: 67
ولكنّه لا يخفى عليك: أنّ هذا الفرض لا يكون جارياً في المشتقّات، كأسماء الفاعلين والمفعولين ممّا هو داخلٌ في محلّ النزاع وموضع النقض والإبرام؛ لأنّ مثل هذا التلبّس (تلبس مّا)، لا يكفي في اعتبار المفهوم في باب المشتقّات، بل صدق المفهوم على الذات يكون دائراً مدار بقاء تلبّس الذات بالمبدأ، كما لا يخفى.
فقد ظهر ممّا ذكرنا ضعف قول القائلين بالأعمّ؛ لأنّ التفريق بين من يتلبّس بالمبدأ في الاستقبال وبين من انقضى عنه المبدأ، تحكّم ومستلزم للترجيح بلا مرجّح.
وأمّا إن كان النزاع لغوياً: فتصوّر مفهوم الموضوع له على القول بالأخصّ في غاية السهولة؛ لأنّ الموضوع له على هذا القول: ذات اتحدت مع المبدأ بنحو من أنحاء الاتّحاد. وأمّا على القول الآخر: فتصوّر مفهومه في غاية الإشكال. نعم، بعد التامّل يمكن تصوّر مفهوم منتزع عن الذات لأجل تلبّسها بالمبدأ في حالة من الحالات، مثل: كون الشيء بحيث ضرب أو قام.
وأظنّ أنّ هذا كافٍ في إبطال القول بالأعمّ. مضافاً إلى أنّ دعوى أنّ واضع الألفاظ في کلّ لغةٍ إذا وضع أسماء الفاعلين وغيرها وضعها للأعمّ ممّن تلبّس بالمبدأ في الحال وممّن انقضى عنه، دون من يتلبّس به في الاستقبال، دون إثباتها خرط القتاد.
ثم إنّه قد أفاد بعض أفاضل عصرنا(قدس سره): أنّ النزاع في المقام واقعٌ في أنّ المشتقّ هل وضع لحصّة من الذات، وهي الّتي التئمت مع المبدأ، بمعنى أنّ الموضوع له، هذه الحصّة الملتئمة مع المبدأ، أو أنّه موضوع لذاتٍ التئمت مع المبدأ في وقتٍ مّا؟
وفيه ما لا يخفى.
الأوّل: قد ظهر ممّا ذكرناه خروج الجوامد الجارية على الذوات عن محلّ النزاع وإن
ص: 68
ذهب بعضهم إلى دخولها في حريم النزاع، وتبعهم المحقّق الخراساني(قدس سره) في الكفاية،((1)) واستشهد عليه بما عن الإيضاح((2)) فيمن كانت له زوجتان كبيرتان مدخولتان وزوجة صغيرة، فأرضعت الكبيرتان زوجته الصغيرة - على الترتيب - حيث قال: إنّه تحرم الكبيرة الاُولى والصغيرة. أمّا الثانية ففي حرمتها خلاف، واختار والدي المصنّف((3)) وابن إدريس((4)) حرمتها؛ لأنّ هذه يصدق عليها أنّها اُمّ زوجته، لأنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المشتقّ منه.
وما في المسالك((5)) أيضاً من ابتناء حكم هذه المسألة على الخلاف في المشتقّ.
وتوضيح الوجه في عدم جريان النزاع بناءً على كونه لغوياً هو: أنّ الموضوع له على القول بالأعمّ ذلك الأمر الاعتباري المنتزع عن الزوجية - أي العلاقة الثابتة بين الزوج والزوجة - في حال ثبوتها، فما دامت الزوجية والرابطة الخاصّة بين الزوجين باقية يصدق الزوج والزوجة، وإلّا فبمجرّد زوالها يزولان؛ إذ هما حاكيان عن تلك العلاقة وثبوتها. وليس لهما مفهوم آخر غيرها حتى يصدقا بسبب ذلك المفهوم على من كان في الزمان الماضي زوجاً لامرأةٍ أو زوجةً لرجل.
وأمّا بناءً على كون النزاع عقلياً، فيمكن القول بعدم الفرق بين الجوامد والمشتقّات،
ص: 69
ولكنّه قد ذكرنا ما يظهر به فساد القول بالأعمّ، وأنّ الأمر يدور مدار وجود المناط وجهة الصدق، مثل وجود الزوجية في المثال، فمع وجودها يصحّ إطلاق الزوج أو الزوجة على الذات، ولا يصحّ مع عدم وجود الملاك.
ثم إنّه يمكن أن يؤتى بالمثال لما نحن فيه بوجهٍ آخر، وهو: فيما إذا كانت للمرء زوجةٌ صغيرةٌ فطلّقها وبعد الطلاق أرضعتها إمرأته، فلو قيل بأنّه يصدق على المرضعة أنّها اُمّ زوجته لا يجوز له نكاحها، وأمّا لو قيل بعدم صدقها عليها فيجوز له نكاحها.
والظاهر أنّ منشأ التعرّض لبيان المثال الأوّل وجوده في الرواية الّتي فيها تخطئة ابن شبرمة القائل بحرمة المرضعة الثانية أيضاً، فبيّن الإمام أبو جعفر(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) خطأه بقوله: «حرمت عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أوّلاً، وأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه لأنّها أرضعت ابنته».((1))
وهنا ظهر عدم ابتناء حرمة المرضعة الاُولى على النزاع في المشتقّ.
وأمّا ما قيل في ابتنائه على ذلك بأنّ الاتّصاف بالاُمومة إنّما يكون في وقت خروج الصغيرة عن الزوجية وصيرورتها بنتاً فلا تكون الكبيرة الاُولى في زمانٍ من الأزمنة اُمّ الزوجة الفعلية حتى تحرم عليه، وإنّما هي اُمّ من كانت زوجته فتبتني حرمة الاُولى أيضاً على ما حقّق في مبحث المشتقّ.
فواضح الفساد؛ لأنّ زوال الزوجية معلولٌ لتحقّق عنوان الاُمومة، والمعلول يكون متأخّراً عن علّته رتبةً بالضرورة، فتحقّق عنوان الاُمومة يكون متقدّماً على زوال عنوان الزوجية، كما لا يخفى.((2))
ص: 70
التنبيه الثاني: لا يذهب عليك أنّه لا يفرق في ما نحن فيه اختلاف مبادئ المشتقّات، وكونها في بعضها حرفة، وفي بعضها ملكة، وفي بعضها غيرهما.((1)) كما أنّه لا يفرق في ما نحن بصدده اختلاف أنحاء التلبّسات، فمنها ما يكون تلبّس الذات به بنحو الحلول كالعلم، فإنّ كيفيّة تلبّس الذات (وهو العالم) به يكون حلولياً؛ ومنها ما يكون التلبّس به بنحو الصدور كالضرب، إذا كان المشتقّ اسم الفاعل؛ ومنها ما يكون بنحو الوقوع كالمضروب؛ ومنها ما يكون على نحو الظرفية وكون الذات ظرفاً للمبدأ كاسم الزمان والمكان.
فإذا نظرنا إلى مبدءٍ كالضرب، فكما أنّ وجوده محتاجٌ إلى شخص يصدر عنه الضرب وهو الضارب (اسم الفاعل)، كذلك هو محتاج إلى شخص يقع عليه وهو المضراب (اسم المفعول)، وإلى آلة بتوسطها يصدر الضرب من الضارب ويقع على المضروب وهي المضرب (اسم الآلة)، وإلى زمان يقع فيه الضرب وهو المضرب (اسم الزمان)، وإلى مكان يقع فيه الضرب وهو المضرب أيضاً (اسم المكان). فالمبدأ في المثال هو الضرب، واختلافه مع سائر المبادئ، كالعلم والكتابة، غير تغاير أنواع التلبّسات الواقعة في اسم فاعله ومفعوله وآلته واسم زمانه ومكانه، فتغاير المبادئ بعضها مع بعض غير تغاير أنحاء التلبّسات بالنسبة إلى مبدأ واحد، فالضرب مبدأ واحد لكن التلبّس به يكون بنحو الصدور كالضارب وبنحو وقوعه على الذات كالمضروب، وبنحو كون الذات آلة لصدور المبدأ من الفاعل ووقوعه على المفعول كالمضرب، وبنحو الظرفية كالمضرب.
هذا، وليكن ما ذكرنا من الفرق بين اختلاف المبادئ وأنواع التلبّسات استدراكاً على الكفاية فإنّها غير متعرّضةٍ لذلك.
التنبيه الثالث: ربما تُوهّم عدم جريان النزاع في أسماء الأزمنة؛ لأنّ الذات فيها وهي
ص: 71
الزمان بنفسه ينقضي ويتصرّم، فلا يمكن وقوع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال، أو فيما يعمّ ما كان متلبّساً به في الماضي؟
وقد أجاب عنه في الكفاية: بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفردٍ، غير موجب لكون اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الفرد دون العامّ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، بأنّه وضع لمفهوم عامّ - مع القطع بانحصاره في الفرد الواحد الأحد جلّ جلاله - أو هو موضوع للفرد.((1))
ويمكن الجواب بأنّه بعد قيام البرهان على بطلان الجزء الّذي لا يتجزّأ وتتالي الآنات لا مجال للقول بأنّ للزمان أجزاءً لا تتجزّأ وآناتٍ متتالية، بل لابدّ من القول بأنّ للزمان وحدة اتّصالية تدريجية هي عين الوحدة الشخصية، فإنّ بعض الحقائق تصرّمه عين بقائه وتجدّده وانقضاؤه عين وجوده، فامتداد الزمان من الاُمور الّتي لا تناهي لها ويكون بعينه ظرفاً للأشياء، ولكنّه مع تصرّمه وتجدّده شيء واحد.
فعلى هذا، تكون الذات في الزمان باقية؛ إذ تصرّمها عين بقائها، فلا مانع من وقوع أسماء الأزمنة تحت النزاع أيضاً.
التنبيه الرابع: لا إشكال في خروج سائر المشتقّات من قبيل الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع؛ لعدم كونها جارية على الذوات.
ذكر المحقّق الخراسانى(قدس سره) في المقام عدم دلالة الأفعال على الزمان، وبرهن عليه بما في الكفاية وبعض فوائده.((2))
ص: 72
ولكن لا يخفى عليك: أنّ ما اختاره في الأمر والنهي صحيح؛ لأنّ مدلولهما مجرد البعث والزجر ولا دلالة لهما على الزمان.
وأمّا الفعل الماضي والمضارع فلا شبهة في كون الزمان مأخوذاً في مدلولهما، ومن الواضح عدم وجود فرق بين «ضَرَب» في اللغة العربية و«زد» في الفارسية وما يراد منهما في سائر اللغات، وبين «يضرب» و«می زند» وما يراد منهما في سائر اللغات إلّا من جهة دلالة «ضَرَبَ» على سبق وقوع الفعل، ودلالة «يضرب» على وقوع الفعل في حصّة من الزمان الصادقة على الحال والاستقبال، فيكون الفعل المضارع مشتركاً معنويّاً بين الحال والاستقبال.
ثم إنّه ذكر المحقّق الخراساني(قدس سره) هنا كلاماً في المعنى الحرفي يخالف المشهور من النحاة أيضاً، وقد استقصينا الكلام فيه سابقاً فلا نعيده خوفاً من الإطالة. هذا تمام الكلام في المقدّمات.
وأمّا الكلام في تأسيس الأصل في المسألة، فاعلم: أنّه لا أصل في المسألة على نحو كلّي يعوّل عليه عند الشكّ في أنّ ما يصدق عليه الضارب - مثلاً - هو الذات مادام تلبّسها بالمبدأ باقياً، أو أنّه الذات ولو بعد انقضاء تلبّسها؟
وأمّا الاُصول العملية في الموارد الجزئية فتختلف بحسب اختلاف الموارد، ففي مثل كراهة البول تحت الأشجار المثمرة يكون الأصل البراءة إذا انقضى عن الشجر المثمر التلبّس بالمبدأ قبل حكم الشارع بالكراهة، ويكون المرجع الاستصحاب إذا انقضى عنه بعد حكمه بالكراهية.
وكيف كان، فقد اختلفوا في أصل المسألة، فمنهم من زعم أنّ المشتقّ حقيقة في
ص: 73
الأعمّ مطلقاً. ومنهم من ذهب إلى أنّه حقيقة فيه إذا كان المشتقّ محكوماً عليه، وفي المتلبّس في الحال إذا كان محكوماً به. واختار بعضهم غير ذلك من الأقوال.((1))
والحقّ ما ظهر من مطاوي ما ذكرناه، وهو كونه حقيقة في من تلبّس بالمبدأ في الحال.
وقد مضى ما يظهر به صحّة القول بكون المشتقّ موضوعاً للأخصّ وضعف القول بالأعمّ.
وصفوة القول بعد ما صارت الجهة المبحوث عنها في المسألة - وهي أنّ حيثية صدق القائم على الذات هل هي القيام بالفعل أو مفهوم يعمّ حال التلبّس والإنقضاء؟- معلومة، أن نقول للقائل بالأعمّ المدّعي للتبادر: كيف يمكنكم إثباته والاستدلال به؟ وقد تبيّن فيما سبق خفاء حيثية الصدق في عالم الاعتبار وعدم وضوحها إلّا بعد التامّل، فما معنى هذا التبادر؟ وأيّ معنى ينسبق إلى الذهن بعد هذا الغموض؟
بيان ودفع إشكال: لا يخفى أنّ المشتقّات المستعملة في لسان أهل المحاورة تارة: تستعمل لأجل مجرّد بيان اتّحاد الذات مع المبدأ استعمالاً حقيقياً، أي في الموضوع له، ففي مثل هذا المورد تجعل الذات موضوعاً والمشتقّ محمولاً، كما في قولنا: زيدٌ ضاربٌ.
وتارة اُخرى: تستعمل لأجل جعلها مرآة لملاحظة الغير، وهذا كما إذا عرف المخاطب الشخص الّذي صدر منه الضرب بعينه ولم يعرفه باسمه، فيقال له: أكرم الضارب، بحيث يجعل الضارب مرآة وآلة لملاحظة الذات الصادر عنها الضرب. وهذا قد استعمل أيضاً في معناه الحقيقي، وبسبب استعماله في ذلك المفهوم يلتفت المخاطب إلى الشخص المعهود.
ص: 74
وثالثة: تستعمل لأجل دخالتها في الحكم وعليّتها له، كما إذا قال: أكرم العالم؛ فإنّ المراد منه بحسب مقدّمات الإطلاق وجوب إكرام كلّ من كان متّصفاً بصفة العلم فعلاً، فلا يتّجه بذلك استدلال القائل بالأعمّ((1)) بقوله تعالى: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾،((2)) وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾؛((3))
حيث يترتّب القطع والجلد بعد انقضاء التلبّس وليس حين التلبّس بالسرقة أو الزنا.
وذلك لعدم التنافي بين ما قلناه وبين ترتّب القطع والجلد في الموردين بعد انقضاء التلبّس؛ لأنّ الحكم بالقطع والجلد يستفاد من مناسبة الحكم والموضوع، حيث إنّهما من وظائف السائسين والحكّام، فلا يمكن أن يكون المراد وجوب إجراء الحدّ على من كان مشغولاً بالزنا والسرقة.
ورابعة: تستعمل في المعنى الحقيقي أيضاً لأجل نفي الحكم عن الذات المتّصف بصفة ولو آناً مّا، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَ-مَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّال-ِمين ﴾،((4)) حيث إنّ المستفاد من قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ﴾ وطلب إبراهيم جعل الإمامة في ذريّته بقوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتي﴾ وإضافة العهد إلى ياء النفس، أنّ منصب الإمامة منصب خطير عالٍ إلهيّ، وأنّ الإمام لابدّ أن يكون منصوباً من الله تعالى، ونصبه من وظائف مقام الربوبية وخصائصه، فلا ينال هذه الدرجة الرفيعة من كان متلبّساً بالظلم ولو آناً مّا. ومقتضى الجمع المحلّى باللام عدم نيل جميع أفراد الظالمين لهذا المقام، هذا.
ولا يخفى، أنّه لا يصحّ أن يكون المراد في الآية الشريفة أنّ المتلبّس بالظلم في حال
ص: 75
الظلم لا ينال عهد الله تعالى؛ لأنّ الظلم ليس من الأوصاف الملازمة للإنسان، بل يكون من الأعراض المفارقة، فإذا قلنا: الظالم لا يتصدّى منصب الحكومة أو السلطنة، فمعناه أنّ من اتّصف بهذه الصفة ولو في وقت من الأوقات غير لائقٍ لحيازة هذا المنصب. ولو كان المراد عدم نيل الظالم له في حال الظلم، لزم من ذلك لياقة كلّ الناس لذلك المنصب الرفيع؛ لأنّه لا يوجد واحد من الظالمين قد تلبّس بالظلم في جميع الأزمنة، كما هو واضح.
لا يخفى عليك: أنّ مفهوم المشتقّ بسيطٌ. ومعناه أنّه عند الإطلاق لا يجيء إلى الذهن من الضارب والعالم مثلاً إلّا الضرب والعلم مبهماً ولا بشرط. نعم، في بعض المشتقّات يكون مفهومه مركباً لأجل تركّب مفهوم مبدئه.
ولا يخفى عليك أيضاً: أنّ مفهوم الذات والشيء غير معتبرٍ في مفهوم المشتقّ على کلّ حالٍ. ومن قال باعتبار أحدهما في مفهوم المشتق إنّما أراد من ذلك اعتبار مصداق الشيء أو الذات في مفهومه، هذا. وقد وقع النزاع في بساطة مفهومه وعدمها بين صاحب الكفاية وصاحب الفصول.((1))
واستدلّ في الكفاية على بساطته بما حقّقه المحقّق الشريف من أنّه لو اعتبرنا مفهوم الشيء في مفهوم الناطق مثلاً، يلزم دخول العرض العامّ في الفصل؛ ولو اعتبرنا ما هو مصداق الشيء، كالإنسان مثلاً، في قولنا: الإنسان ضاحك يلزم انقلاب القضیّة
ص: 76
الممكنة إلى الضرورية؛ لأنّ الشيء الّذي له الضحك هو الإنسان وثبوته لما جعل في القضیّة موضوعاً - وهو الإنسان - ضروريّ.((1))أقول: لا يخفى عدم لزوم المحال من ذلك أصلاً. غاية الأمر أنّه يلزم من صحّة الشقّ الأوّل عدم كون الناطق - مجرّداً - فصلاً، خلافاً لما ذهب إليه المنطقيّون من جعله فصلاً مجرّداً عن الذات.
وأمّا صحّة الشقّ الثاني فغير ملازمة للانقلاب، بل لا يلزم منها إلّا كون القضیّة الّتي زعمها المنطقيّون ممكنةً ضروريةً من أوّل الأمر، لا أنّها كانت ممكنةً ثم انقلبت إلى الضروریّة.
وقال في الكفاية بعد الجواب عمّا أجاب به الفصول باختياره الشقّ الأوّل لدفع الإشكال: «والتحقيق أنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقيّ، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه، وإنّما يكون فصلاً مشهورياً منطقياً يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه بل لا يكاد يعلم... إلخ».
وفيه: أنّه كان من الممكن أن يجعلوا الفصل «النطق»، فافهم.
وأجاب عمّا ذكر في الفصول (من اختياره الشقّ الثاني ودفع الإشكال بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء مطلقاً بل مقيداً بالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذٍ ضرورياً): «بأنّ عدم كون ثبوت القيد ضرورياً لا يضرّ بدعوى الانقلاب... إلخ».
وفيه: أنّ المحمول في القضیّة بناءً على اعتبار مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ يكون مجموع قولنا: «إنسان له النطق» فالمقيّد بما أنّه مقيّد ومع قيده يكون محمولاً لا مطلقاً، فتأمّل جيّداً.
ص: 77
ثم لا يذهب عليك: أنّ المحقّق الخراساني(قدس سره) ذهب إلى خلاف ما يستفاد من كلامه في أوّل الأمر من بساطة مفهوم المشتقّ، فاختار في آخر هذا المبحث تركّب مفهومه. ومحصّل ما أفاده في المقام بعد هذه المناقشات مع الفصول: أنّ مفهوم المشتقّ إنّما يكون بسيطاً بالنظر البدويّ، ولكنّه بعد التأمّل يظهر كونه مركّباً.
وهذا كلام غريبٌ منه؛ لأنّ غالب المفاهيم بل كلّها تجيء إلى الذهن بنحو البساطة، ولا يظهر بعد التامّل كونه مركّباً إلّا أن يكون مفهوم مبدئه كذلك.
لا فرق بين المبدأ والمشتقّ بحسب المفهوم، فمفهوم المشتقّ يكون عين مفهوم المبدأ وبالعكس، فلا فرق بين الضارب والضرب، والعالم والعلم، والضاحك والضحك. ولو قيل بأنّ الضارب هو الذات الّتي صدر عنها الضرب، أو العالم ذات ثبت لها العلم مثلاً؛ فإنّما هو لأجل تفهيم المطلب على المتعلّمين.
نعم، يظهر من هذه العبارات كون معنى الضرب نوع فعل يصدر من الذات، والعلم نوع شيء يحلّ فيها، وهذا یدلّ على اختلاف أنحاء التلبّسات، ولا ربط له بما نحن فيه.
إن قلت: فعلى هذا، لا مانع من حمل المبدأ على الذات أيضاً كالمشتقّ.
قلت: المانع كون المبدأ آبياً عن حمله على الذات، بخلاف المشتقّ فإنّه لا يأبى عن ذلك؛ لأنّ المشتقّ مفهومه الضرب مثلاً، ولكن بحيث يمكن أن يكون تمام تحصّله ذلك أو جهة اُخرى، فالضرب المبهم مفهوم المشتقّ بخلاف المبدأ، فإنّ مفهومه هو الضرب الّذي كان تمام تحصّله ذلك، ولا يكون فيه إبهام، فيكون المانع من حمل المبدأ على الذات كون المفهوم في المشتقّ لا بشرط وفي المبدأ بشرط لا.
ص: 78
وليس المراد من لا بشرطية المشتقّ وبشرط لائية المبدأ ما يراد منهما في مبحث الماهية، بل هو ما يراد منهما في الفرق بين الجنس والفصل والمادّة والصورة.
وتوضيح ذلك: أنّ المرکّبات على قسمين:
قسمٌ تكون له أجزاء في الخارج وإن كان يعدّ في نظر العرف شيئاً واحداً، وتتصوّر له ماهية واحدة بحيث تسع وتشمل جميع الأجزاء؛ ففي هذا القسم لا يصحّ حمل الجزء على الكلّ وحمل الكلّ على الجزء. والوحدة فيه تكون لا محالة اعتبارية، والكثرة حقيقية، وتركيبه يكون تركيباً انضمامياً.
وقسم ليس له أجزاء في الخارج وإن كان عند التأمّل والاعتبار ينحلّ إلى جزءين أو إلى أجزاء؛ ففي هذا القسم يكون الجزء عين الكلّ والكلّ عين الجزء، وتكون وحدته حقيقية، كما تكون كثرته اعتبارية، كالإنسان، وتركيبه يكون اتّحادياً.
وفي هذا القسم ذهب أهل المعقول إلى أنّ مجرد ذلك لا يصير موجباً لصحّة حمل الجزء على الكلّ والكلّ على الجزء؛ لأنّا إذا نظرنا إلى شيء فتارة نراه تامّ التحصّل بحيث لا تفرض في رؤيتنا جهة إبهام، وتارة نراه مبهماً ومن غير أن يكون تمام تحصّله ما يقع تحت نظرنا من حالاته وكيفياته، بل بحيث يمكن أن تكون له تحصّلاتٌ وتشخّصاتٌ غير ذلك، مثلاً: إذا نظرنا إلى البحر فتارة يكون نظرنا مقصوراً على الماء الموجود في المكان الكذائي المحدود بحدودٍ خاصّةٍ بحيث يكون تمام تحصّله وجوده في هذا الحدّ من المكان، فلو نظرنا إلى البحر في مكان آخر نحكم بمباينة الماء الموجود في هذا المكان مع الماء الّذي رأيناه سابقاً، وتارة ننظر إلى الماء الّذي يكون في مكان من البحر، ولكن لا من جهة كونه في هذا المكان ومحدوداً بحدٍّ خاصّ، ومن غير أن يكون تمام تحصّله وجوده في ذلك المكان وتخصّصه بهذه الخصوصيات، ففي هذه الصورة يكون الماء الموجود في مكانٍ آخر من البحر عين هذا الماء، بحيث لو قلنا بأنّ هذا هو ما نراه سابقاً لكان صحيحاً.
ص: 79
إذا عرفت ذلك، فنقول: إذا نظرنا إلى الحيوان وأخذنا تحت النظر تمام الماهية المشتركة بين الإنسان والبقر والغنم وغيرها، بحيث يكون تمام تحصّله ذلك، وكذلك لو نظرنا إلى الناطق بما أنّه مميّز الإنسان عن سائر الأنواع، فبحسب هذا النظر لا يمكن حمل أحدهما على الآخر، فلا يصحّ أن يقال: «الناطق حيوان أو الحيوان ناطق»، ولا يمكن حمل الإنسان عليهما، وحملهما عليه. وهذا ما يعبّر عنه بالمادّة والصورة العقلية، ويكون التركيب بينهما انضماميّاً.
وأمّا لو نظرنا إلى الحيوان لا بنحو يكون تمام الماهية المشتركة بين الإنسان وسائر الأنواع، بل نظرنا إليه وأخذناه مبهماً من دون أن يكون تمام تحصّله كونه تمام الماهية المشتركة بين الإنسان وغيره، أو شيء آخر. كذلك في طرف الناطق إذا أخذناه تحت النظر من غير أن يكون تمام تحصّله جهته المميّزة، أو جهة اُخرى، فلا مانع من حمل أحدهما على الآخر، فيصحّ أن يقال: بأنّ «الناطق حيوان والحيوان ناطق»، وحمل الإنسان عليهما، وحملهما عليه بأن يقال: «الإنسان حيوان والحيوان إنسان، أو الناطق إنسان والإنسان ناطق». ويعبّر عن هذا بالجنس والفصل، ويكون التركيب بينهما اتّحادياً.
وبما ذكرنا ظهر الفرق بين المادّة والصورة والجنس والفصل، فالجزء المتصوّر إذا اُخذ كما ذكرنا لا بشرط يكون جنساً أو فصلاً، وإذا اُخذ بشرط لا يكون مادّة أو صورةً.
واللا بشرط المذكور في المقام وكذا البشرط لا غير ما هو المذكور في تقسيمات الماهية واعتباراتها، فتارةً: تعتبر الماهية بشرط الوجود ويعبّر عنها بالماهية بشرط شيء، وتارة: تعتبر بشرط لا وهي الماهية الّتي لا يكون لها حظٌ من الوجود، وثالثة: تعتبر لا بشرط أن يكون معها الوجود.
ولا يخفى عليك: أنّ الفرق بين اللا بشرطية المذكورة في مبحث الماهية واللا بشرطية المذكورة في الجنس والفصل: أنّ الماهية في الأوّل تلحظ لا بشرط وبدون القيد حتى
ص: 80
اندكاكها في القيد، بخلاف الأخيرة، فإنّ الماهية تكون ملحوظة بما أنّها مندكّة في القيود سواء كان تمام تحصّلها وحيثيّتها بما نرى من القيود، أو كان بأشياء اُخر.
ثم إنّه قد ظهر ممّا ذُكر وجه ما أفاده أهل المعقول من كون کلّ من الجنس والفصل جزءاً للحدّ لا المحدود، لأنّ فرض كونهما جزءين للمحدود منافٍ لحمل أحدهما على الآخر، وحمل الكلّ على الجزء، فلو قلنا في تعريف الإنسان بأنّه حيوانٌ ناطقٌ، لا يكون الحيوان وكذا الناطق جزءاً للإنسان بل هما جزءان لحدّه.
ولا يخفى عليك: أنّ مبنى القول بلا بشرطية المشتقّ وبشرط لائية المبدأ ثلاثة اُمور:
أحدها: كون الأعراض من مراتب وجود المعروضات وأنحائه، فإذن لا محالة يكون التركيب بين العرض والمعروض اتّحادياً.
ثانيها: قول أهل المعقول بأنّ الفرق بين الجنس والفصل والمادّة والصورة العقليتين كون الأوّليين لا بشرط والاُخريين بشرط لا.
ثالثها: كون المشتقّ بالنسبة إلى الذات عرضاً والذات معروضة.
هذا، ولا يذهب عليك عدم صحّة ما أفاده في الكفاية((1)) في معنى لا بشرطية مفهوم المشتقّ من كونه غير آبٍ عن الحمل، وفي معنى بشرط لائية مفهوم المبدأ من كونه آبياً عن الحمل، وذلك لما ذكرنا في مقام الفرق بينهما من أنّه إذا لوحظ الشيء تامّ التحصّل وبأن يكون الملحوظ تمام حيثيته الوجودية ووضعنا اللفظ بإزائه يصير المفهوم بشرط لا وآبياً عن الحمل. وإذا اعتبرناه غير تامّ التحصّل بل بنحو يمكن أن يكون تمام تحصّله وحيثيته الوجودية ما نرى منه من القيود، ويمكن أن يكون تحصّله لجهاتٍ اُخرى يصير مفهوم اللفظ لا بشرط ولا يأبى عن الحمل، فتدبّر.
ص: 81
لا ريب في صحّة حمل القادر، والعالم، والحيّ، والمريد، وغيرها من الأسماء الحسنى على الله تعالى، إلّا أنّه لمّا يتراءى لزوم تغاير المبدأ مع ما يجري عليه المشتقّ ولم يكن لله تعالى حيثٌ وحيثٌ بمعنى أنّه لا تكون له حيثيةٌ يصدق عليه لتلك الحيثية أنّه عالمٌ وحيثيةٌ اُخرى موجبة لصدق القادر، أو الدائم، أو القديم، أو غيرها عليه تعالى؛ وإلّا لزم تركّب ذاته المقدّسة.
ذهبت الأشاعرة((1)) إلى قيام العلم والقدرة وسائر الصفات بذاته المقدّسة وتغايرها معها، وأنّ کلّ هذه الصفات قديمة كذاته تعالى، لأنّه لو لم تكن قديمة يلزم خلوّ ذاته تعالى عنها في رتبته المتقدّمة على قيام الصفات به تعالى.
ولازم قولهم هذا تعدّد القدماء، وفساده من الواضحات.
ولذا ذهبت المعتزلة((2)) إلى القول بنيابة الذات عن هذه الصفات، بمعنى أن ليس لله تعالى علمٌ، ولا قدرةٌ، ولا الصفات الاُخرى، ولكن يظهر منه آثار هذه الصفات.
تعالى الله عمّا يقول الأشاعرة والمعتزلة علوّاً كبيراً.
والتحقيق: عينيّة الصفات والذات، بمعنى كون علمه وقدرته وحياته وغيرها عين ذاته البسيطة، فما هو حيثية صدق العالم والقادر والقديم عليه تعالى، ذاته المقدّسة الأزلية. ولا يلزم تغاير المبدأ ومن يجري عليه المشتقّ؛ لأنّا نرى بالوجدان صحّة حمل القديم على بناءٍ مضى من تاريخ بنائه ألف عامّ بالنسبة إلى بناءٍ قبل خمسمائة عامّ، ولا
ص: 82
يكون معنىً لقدمه إلّا وجوده في تمام هذه المدّة، فلا تكون حيثية صدق القديم عليه غير وجوده الكذائي، ولا يكون ماوراء ذات البناء شيءٌ يكون قائماً به.
وأمّا الحياة فلو كانت حقيقتها ما يتصوّر بالنسبة إلى الإنسان والحيوان - وهو تحقّق علاقة الروح بالبدن، وفي مقابله الموت الّذي هو عبارة عن زوال لياقة البدن لتعلّق الروح به - فلا يخفى عدم تصوّر الحياة بهذا المعنى لله تعالى، بل لا يمكن تصوّر الحياة بهذا المعنى بالنسبة إلى سائر الموجودات الحيّة من الأرواح والملائكة والنبات والجماد.
أمّا لو كان معنى الحياة معنى يصحّ إطلاقه على جميع الموجودات الحيّة وهو ظهور الآثار المترقّبة عن الشيء بأسرها منه، وبهذا المعنى يقال: الله تعالى حيٌّ، والإنسان حيٌّ، والمعدن حيٌّ، والماء حيٌّ، فمعنى كونه تعالى حيّاً بروز جميع آثار واجبية الذات عنه تعالى، وهذا كما ترى لا يكون شيئاً ماوراء الذات حتى يكون قائماً به تعالى. وهكذا نقول في العلم فإنّه الإنكشاف، وهذا أيضاً ليس شيئاً غير الذات.
ص: 83
ص: 84
وفيه فصول:
الفصل الأوّل: فيما يتعلّق بمادّة الأمر
الفصل الثاني: فيما يتعلّق بصيغة الأمر
الفصل الثالث: في الإجزاء
الفصل الرابع: في مقدّمة الواجب
الفصل الخامس: في مسألة الضدّ
الفصل السادس: في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
الفصل السابع: في الواجب التخييري
الفصل الثامن: في الواجب الكفائي
الفصل التاسع: في الواجب المطلق والموقّت
الفصل العاشر: في متعلّق الأوامر والنواهي
ص: 85
ص: 86
والكلام فيه يقع في جهات:
قال الجوهري: «أمرته بكذا أمراً. والجمع الأوامر».((1))
ولا يخفى: أنّ جمع الأمر على الأوامر من الجموع النادرة.
والقول بأنّه جمع الآمرة بحذف الموصوف (أي الصيغة أو الكلمة الآمرة) فيكون المراد من الأوامر: الكلمات الآمرة والصيغ الآمرة، بعيد عن الذهن كما يشعر بذلك كلام مولانا أمير المؤمنين(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في دعاء كميل: «وخالفت بعض أوامرك»؛ فإنّه بعيد في الغاية حمل لفظ الأوامر المذكور في كلامه(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) على هذا المعنى، بل المستفاد منه الطلب المخصوص الّذي يكون مرادفه بالفارسية لفظ «فرمان».
وعلى کلّ حال اختلفوا في معنى لفظ الأمر، وذكروا له معاني عديدةً:
منها: الشأن، والطلب، والفعل، والفعل العجيب، والغرض، وغيرها. والظاهر
ص: 87
أن الأمر ليس كذلك في جميع المعاني المذكورة؛ فإنّه لا يستعمل في الفعل في كلامهم. وأمّا قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾؛((1)) فالظاهر أنّ المراد به المعنى الحدثي وما يشتقّ منه الأفعال وغيرها.
وكذلك الفعل العجيب، فلا يستعمل الأمر في كلامهم في الفعل العجيب أيضاً؛ واشتباه بعض الاُصوليين في ذلك إنّما نشأ من موافقة مادّة الأمر بفتح الهمزة مع الإِمر بكسرها، حيث إنّ الإِمر بالكسر بمعنى الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً﴾.((2))
وأمّا الغرض، في مثل قولنا: «جاء زيد لأمر كذا» فإنّ ما یدلّ على الغرض هو اللام ويكون مدخوله مصداقه.
وأظنّ أنّ لفظ الأمر مشترك((3)) بين معنيين:
أحدهما: المعنى الحدثي الّذي تشتقّ منه الأفعال وغيرها.
ثانيهما: المعنى الجامد الّذي يكون عبارة عن الشيء، بل يكون أخصّ منه؛ لأنّ الشيء يطلق على الجواهر، فيقال: زيدٌ شيءٌ، ولا يقال: زيدٌ أمرٌ. ولكن يصحّ قولك: أتيتك لأمر من الاُمور، والأمر الّذي معناه هذا يكون جمعه الاُمور، ولا نظر للاُصولي في تعيين معناه.
اختلف الاُصوليون - بعد اتّفاقهم على دلالة الأمر على الطلب - في اعتبار كون
ص: 88
الطلب من العالي حتى لا يكون الطلب من المساوي، أو السائل أمراً. وكذلك في اعتبار الاستعلاء وعدمه.
والّذي ينبغي أن يقال: إنّ الطلب على قسمين:
قسم: يصدر من الطالب لأجل أن يكون موجباً للانبعاث وسبباً لتحريك الغير، ويكون موجب الانبعاث والتحريك مجرّد ذلك الطلب بدون ضمّ ضميمةٍ.
وقسم: لا يكون كذلك، بل ينشأ الطلب ويضمّ معه شيء آخر من الإصرار والاسترحام والتطميع والتعظيم والدعاء وغيرها، فلا يكون مجرّد إنشاء هذا الطلب باعثاً ومحرّكاً.
فإذا كان الطلب من القسم الأوّل يكون أمراً. وإذا كان من قبيل الثاني يكون سؤالاً أو التماساً. فبناءً عليه لا يعتبر في معناه العلوّ ولا الاستعلاء. نعم، لو طلب المساوي أو السافل بالنحو الأوّل يذمّه العقلاء ويقبّحونه، لأنّ اللائق بهذا الطلب الكذائي إنّما هم الموالي بالنسبة إلى عبيدهم ومن يجري مجراهم.
لا يخفى عليك: أنّ المحقّق الخراساني(رحمه الله) وإن ذكر في الجهة الثالثة كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب،((1)) ولكن الأولى بيان ذلك في الجهة الرابعة، فإنّ اللازم بيان حقيقة الطلب أوّلاً ثم البحث في أنّ الوجوب الذي هو قسم من الطلب هل هو مفهوم الأمر أم لا؟ فعلى هذا، ينبغي لنا تقديم البحث عن حقيقة الطلب، فنقول بعون الله تعالى:
إنّ القوم حيث قسّموا الطلب إلى قسمين: الوجوب والندب، صاروا بصدد بيان
ص: 89
حقيقة الطلب. وحيث إنّ البحث عن ذلك مرتبط بالبحث عن اتّحاد الطلب والإرادة وعدمه الّذي يكون من شعبات المسألة المعروفة الكلاميّة الّتي وقع فيها الاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة - وهي أنّ صفة التكلّم من صفات الذات، أو الفعل؟ - ساقوا الكلام في تحقيق اتّحاد الطلب والإرادة، ولكن لم يبيّنوا محلّ الاختلاف والنزاع مفصّلاً ولم يأتوا بما يوضّح المرام، بل خرج بعضهم عمّا هو محلّ النقض والإبرام، فاللازم توضيح جهة النزاع ومنشأ الاختلاف بنحو يتّضح روح البحث وما هو الحقّ في المقام.
فنقول: إنّ المسلمين في صدر الإسلام تلقّوا الآيات والأخبار غالباً من غير أن يتعمّقوا في مضامينها ويبحثوا في مراداتها، بل کانوا يأخذونها من صاحب الشرع صلوات الله عليه وآله ويحفظونها ككنوز جواهر لا يعلم حافظها ما فيها، ولمّا وصلت النوبة إلى عصر الصحابة و رأوا شدّة اهتمام الإسلام بتحصيل العلم، والتفتوا إلى أنّ الواجب عليهم تحصيل العلوم، صاروا مهتمّين بتعلّم العلوم وإعمال التفحّص في سبيلها وعقدوا في المساجد حلقات تذاكروا فيها تفسير القرآن المجيد، وتحادثوا بما سمعوه عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ). وفي هذا العصر اطّلع المسلمون على ما في أيدي الناس من الأفكار والآراء لأجل اختلاطهم ومعاشرتهم مع غيرهم من الملل المختلفة، لاسيّما في عصر التابعين الّذي كثر فيه الأسرى العارفون بآراء مللهم في مبدأ العالم وصفاته تعالى، وكيفيّة تكوّن العالم وغيرها، وقد كان بعض هؤلاء الأسرى يحضر بعض تلك الحلقات ويطرح هذه الآراء، وكان أكثر تشكيل تلك الحلقات في مساجد مكّة والمدينة المكرّمتين والكوفة والبصرة.
وممّن كان له حلقة بحثٍ في مسجد البصرة الحسن البصري، وربّما حضر في حلقة بحثه بعض المطّلعين على بعض الآراء من الملّيّين، وصارت نظرياته منشأً لبحثهم في صفات الله تعالى، ومزيد اهتمامهم في فهم ما جاء في القرآن الكريم من الصفات الجارية عليه تعالى، كالعالم، والقادر، والمتكلّم، وغيرها. وقد وقع لواصل بن عطاء
ص: 90
أحد تلامذته معه اختلافٌ في بعض المسائل، فاعتزل من حلقته وجلس في ناحية اُخرى من المسجد، ووافقه في الاعتزال بعض التلامذة. ومن ذلك الزمان اُسّس مذهب الاعتزال، إلى أن نشأ أبو الحسن الأشعري الذي كان في بداية أمره من المعتزلة وممّن يرى رأيهم ويسلك سبيلهم، ثم رجع عن ذلك وأخذ طريقة الحسن البصري ومن يحذو حذوه، واهتمّ بردّ آراء المعتزلة وسمّاهم بأهل البدعة، كما سمّى نفسه وموافقيه بأهل السنّة. وذهب في صفات الله تعالى إلى قيامها بالذات قياماً حلولياً. وحيث رأى أنّ القول بحدوث الصفات ملازم لخلوّ الذات منها في المرتبة المتقدّمة على حدوثها ذهب إلى قدم صفاته تعالى، ولم يتحاش من تعدّد القدماء، فخالف المعتزلة الّذين قالوا بالنيابة.
وأثبت الكلّ لله تعالى صفات ثبوتية وسلبية، وأنّ صفاته الثبوتية على قسمين: صفات الذات وصفات الفعل. لکنّهم اختلفوا في التكلّم وكونه من صفات الذات أو الفعل فذهبت المعتزلة((1)) إلى أنّه من صفات الفعل،((2)) كما هو الحق عند الإمامية. وقالوا بأنّنا ما نفهم من الكلام إلّا تلك الأصوات والحروف المسموعة المنتظمة، ولا فرق فيه بيننا وبين الله تعالى، إلّا أنّه تعالى يوجد الكلام في الأشياء كشجرة موسى(عَلَيْهِ السَّلاَمُ). فمعنى التكلم إيجاد الأصوات والحروف.
وذهبت الأشاعرة((3)) إلى أنّ الكلام صفة من صفات الذات، كالعلم والقدرة، ولا فرق فيه بيننا وبينه تعالى. وعبّروا عنه بالكلام النفسي. وقالوا بأنّنا إذا تکلّمنا بکلامٍ فلا
ص: 91
محالة يكون في نفسنا شيء نعبّر عنه بالكلام اللفظي ونحكي بسببه عنه وهذه الصورة النفسية هي ما نسمّيها بالكلام النفسي، والكلام اللفظي حاكٍ عنه.((1))
وقالت المعتزلة في ردّهم: إنّ الكلام لا يخلو إمّا أن يكون من الجمل الخبرية أو الإنشائية، فلو كان من الجمل الخبرية فلا نجد في ذهننا إلّا العلم بما أخبرنا شيئاً نسمّيه بالكلام النفسي. ولو كان من الجمل الإنشائية، فإن كانت الجملة أمرية فلا يكون في أنفسنا بحذائها شيء غير الإرادة، وإن كانت زجرية فلا يكون غير الكراهة، فما هذا الكلام النفسي الّذي تقولون بأنّ الكلام اللفظي يكون حاكياً عنه، ونحن لا نرى بالوجدان غير الإرادة والكراهة والعلم، صفةً اُخرى تكون وراءها.
ومن هنا ظهر منشأ نزاعهم في اتّحاد الطلب والإرادة وعدمه؛ لأنّ من شعب النزاع والاختلاف في الكلام النفسي أنّ الجملة الإنشائية لو كانت بعثية تكون حاكية عن الطلب النفسي الّذي يكون مغايراً للإرادة على مذهب الأشعري.
وأمّا على مذهب المعتزلة فلا يكون شيء في النفس غير الإرادة، وإنّما تكون الجمل الإنشائية الأمرية حاكية عن الإرادة، فيكون الطلب متّحداً مع الإرادة، لكن لا بمعنى اتّحادهما حقيقة، فإنّ الطلب اللفظي وما هو حاكٍ عن الإرادة يكون مغايراً معها بالضرورة، بل مرادهم من الاتّحاد حكاية الجمل الإنشائية البعثية عن الإرادة.
ص: 92
ففي الحقيقة: القول باتّحاد الطلب والإرادة راجع إلى إنكار الطلب النفسي، وأ نّه لا يكون غير الإرادة في النفس شيء نسمّيه بالطلب النفسي. كما ظهرت أيضاً مناسبة البحث عن الطلب والإرادة في الاُصول في هذا المقام.
والحاصل: أنّ النزاع واقع في أنّه هل توجد صفة في النفس غير الإرادة یدلّ عليها الطلب اللفظي، دلالة المسبّب على السبب، أم لا؟
ونحو ذلك يقال في الجمل الخبرية، فهل يوجد في أنفسنا شيء غير العلم تدلّ عليه الجمل الخبرية، أم لا؟ وقس على هذا الاختلاف الواقع في الجمل الإنشائية الزجرية؛ فإنّ الاختلاف بالنسبة إليها راجع إلى وجود صفة في النفس غير الكراهة وعدمه.
ومرجع الكلّ إلى أنّه هل تكون سوى الصفات المعروفة صفة في النفس تكون قائمة بها قياماً حلولياً نعبّر عنها بالكلام النفسي، ويدلّ عليها الكلام اللفظي، دلالة المسبّب على السبب، أم لا؟ فالأشاعرة اتّفقوا على الأوّل، والعدلية على الثاني.
وهذا البحث، أي البحث عن الكلام - الّذي مرجعه إلى البحث في أنّ القرآن مخلوق وحادث، أو قديم؟ -، أوّل بحث وقع بينهما في صفات الله تعالى، لمّا صاروا بصدد البحث وتصحيح العقائد وتطبيقها على ما ورد عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، ولذا سمّي علم الكلام بالكلام((1)) مع احتوائه على المباحث الكثيرة غير مبحث الكلام.
ولا ريب أنّ البحث في الكلام بحث دينيّ كلاميّ بحت، وينادي بالمغايرة مع ما في كتب الاُصول، فإنّ المتاخّرين من الاُصوليّين ادخلوه فى الاُصول بعدما لم يكن لهذا البحث أثرٌ في كتب المتقدّمين، ولم يلتفتوا إلى ما هو محلّ النزاع وروح الاختلاف. وأوّل من ذكره في الاُصول المحقّق صاحب الحاشية(قدس سره).((2)) وتوهّم أنّ المراد من اتّحاد الطلب
ص: 93
والإرادة ترادفهما، وأنّ مراد القائل بمغايرتهما تغايرهما بحسب الموضوع له، وأنّ الموضوع له في الطلب الطلب الإنشائي وفي الإرادة الصفة المعهودة.
مع وضوح أنّ هذا غير لائق بأن يبحث عنه الأشاعرة والمعتزلة ويتعبوا أنفسهم بتسويد صفحات عديدة من الكتب الكلامية؛ لأنّ المسألة تصير على هذا مسألة لغوية.
وتبعه بعده سائر الاُصوليين، حتى وصلت النوبة إلى المحقّق الخراساني(رحمه الله) ، فهو وإن كان يظهر من بعض ما أفاد في المقام((1)) إلتفاته إلى ما هو محلّ النزاع في علم الكلام ولكن يظهر من بعض عباراته خلاف ذلك، فكأنّه تارة إلتفت إلى محلّ النزاع، واُخرى أغمض عنه ولذا أصلح بزعمه بين الطائفتين العدلية والأشاعرة، وقلع أساس النزاع بما حقّقه.((2))
وحاصل ما أفاده(قدس سره): أنّ الطلب والإرادة موضوعان لماهية واحدة وهي الإرادة العينية. ولهذه الماهية - وهو الموضوع المتصوّر - وجود خارجي وهو الطلب والإرادة الحقيقية العينية، ووجود اعتباري وهو الطلب والإرادة المنشاءان باللفظ.
فالعدلية إنّما ذهبوا إلى اتّحاد الطلب والإرادة بحسب الوجود الخارجي، وأنّ ما يدلّ عليه لفظ الإرادة هو ما يدلّ عليه لفظ الطلب، وإلى اتّحادهما أيضاً بحسب الوجود الذهني، وإلى اتّحادهما أيضاً في عالم الإنشاء.
والأشاعرة إنّما ذهبوا إلى تغايرهما بملاحظة تغاير الطلب الإنشائي مع الإرادة الخارجية.
هذا، ولكن يظهر ممّا أسلفناه فساد هذا التحقيق أيضاً؛ لأنّ النزاع كما ذكرنا لا يكون إلّا نزاعاً دينياً بحتاً ولا يكون نزاعاً لفظياً، فالأشاعرة إنّما ذهبوا إلى وجود صفة غير الصفات المعهودة في المتکلّم وسمّوها بالكلام النفسي، والعدلية على خلاف ذلك، فالنزاع واقع في وجود هذه الصفة وعدمها. ولو عبّرت العدلية عن مرادهم بالاتّحاد
ص: 94
فليس مقصودهم اتّحاد الطلب والإرادة حقيقة؛ لأنّ من الواضح عدم اتّحاد هذا الإنشاء المخصوص مع الإرادة الّتي تكون من الصفات النفسانية، بل مرادهم من اتّحادهما: دلالة الطلب على الإرادة دلالة المعلول على العلّة.
هذا، مع أنّ المعروف والمسلّم عند أهل المعقول تقسيم الوجود إلى العيني، والذهني، والكتبي، واللفظي، وإنّما يطلق الوجود على اللفظي والكتبي مسامحةً من جهة حكاية اللفظ والكتابة عن الوجود.
والمحقّق المذكور زاد في الكفاية على الأقسام الأربعة قسماً خامساً وهو الوجود الاعتباري الّذي سمّاه في المقام بالإرادة والطلب الإنشائي،((1)) مع أنّ الحقائق والاُمور الحاصلة في الخارج غير قابلة للاعتبار، فلا يعقل اعتبار وجود الإرادة - الّذي يكون وعاؤه عالم العين - في عالم الاعتبار؛ لأنّ الاعتبارات بعضها يكون له ما بحذاء في الخارج كالفوقية والتحتية والاُبوّة والبنوّة، وتنتزع هذه العناوين من جهة خصوصيات الوجودات العينية بالنسبة إلى وجودٍ آخر، وبعضها لا يكون له ما بحذاء في الخارج، وهذا ينتزع من جعل من بيده الاعتبار ووضعه، كالحكومة والولاية، فإنّ الحكومة مثلاً تنتزع من نصب السلطان أحداً ليتولّى أمر بلدٍ، وكذلك البيع، فإنّه ينتزع من إيجاب البائع وقبول المشتري. وعلى کلّ حالٍ، لا يكاد يتصوّر الوجود الاعتباري للحقائق الموجودة في عالم العين.
ثم إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه: أنّ حقيقة الطلب عبارة عن وجود إنشائي اعتباري ينشأ بالجمل الإنشائية البعثية ويعتبر وجوده في عالم الاعتبار بإنشاء المنشى ء، ويكون مجرّد إنشاء الآمر والباعث حاكياً عن إرادته هذه.
ص: 95
ثم اعلم: أنّ الأشاعرة قد تمسّكوا لما ذهبوا إليه بدليلين:
ص: 96
أحدهما:((1)) أنّه لو لم تكن في المتکلّم غير الإرادة صفة یدلّ عليها الطلب اللفظي فما هو مدلول الأوامر الصادرة عن الله تعالى الّتي لا تكون متعلّقاتها مرادةً له تعالى، كأمره تعالى الخليل بذبح ولده، حيث إنّ الله تعالى لم يرد منه الذبح، فما المحكيّ عنه في تلك الموارد؟ وهل يكون غير الطلب النفسي شيء؟ وهل يصحّ بعد ذلك قول القائل بعدم تعقّل صفة قائمة بالنفس غير الصفات المعروفة؟ فعلى هذا، فما یدلّ عليه الطلب اللفظي ليس إلّا الطلب النفسي القائم بذاته تعالى أزلاً.
وثانيهما: ما ذكره في الكفاية((2)) [كما أشار إلى الأوّل،] وهو أنّه لو لم تكن غير الصفات المعروفة صفة یدلّ عليها الكلام اللفظي، يلزم تخلّف إرادته تعالى عن المراد في تكليفه الكفّار وأهل العصيان، حيث أنّه أمر الكفّار بالإيمان، والعصاة بالواجبات، ولم يصدر منهم الإيمان وفعل الواجبات، وتخلّف إرادته عن مراده محال فلم يرد منهم الإيمان وأداء الفرائض البتّة. فما یدلّ عليه الطلب اللفظي هو الطلب النفسي، لا الإرادة.
والجواب عن الأوّل: أنّ الآمر تارة يأمر المأمور بفعل لحصول كمال له بسبب إتيانه ذلك الفعل. واُخرى يأمره به لأن يأتي بمقدّماته وجميع ما يتوقّف عليه الفعل، مع علمه بوجود المانع عن حصول الفعل، وذلك أيضاً لحصول الكمال للعبد.
ولا يخفى: أنّه في الأوّل أراد نفس الفعل، وفي الثاني أراد المقدمات. وقصة أمر الخليل(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بذبح ولده من قبيل الثاني، لأنّ الله أمره - لحصول الكمال له - بإتيانه جميع المقدّمات بحيث يساوق إتيانها الإتيان بالذبح عادةً لولا طروّ المانع، ولو أمره بالمقدّمات لا يحصل له ذلك الكمال وهو كونه بجميع وجوده وحقيقته مطيعاً للمولى، بحيث يذبح ولده في سبيل طاعته ورضاه. فالله تعالى لم يرد منه الذبح، بل أراد المقدّمات بأمره بالذبح. وقوله تعالى: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾((3)) دليل على اكتفائه بإتيان المقدّمات. ويكون أمره تعالى بالذبح كاشفاً عن إرادته تعالى لوصول عبده إلى الكمال.
وأمّا الجواب عن الثاني: فأجاب عنه المتکلّمون من العدلية بأنّ إرادة الله تعالى إذا تعلّقت بما هو فعله تعالى فلا يمكن تخلّفها عن المراد، وأمّا إذا تعلّقت بصدور فعل عن الغير بإرادة ذلك الغير فلا.((4))
وقال في الكفاية في مقام الجواب: بأنّ المستحيل تخلّفه عن المراد إرادته التكوينية دون إرادته التشريعية. وفسّر الاُولى بالعلم بالنظام على النحو الكامل التامّ، والثانية بالعلم بالمصلحة في فعل المكلّف.((5))
ولا يخفى عدم احتياج الجواب إلى بيان ماهيّة الإرادتين وأخذ ذلك من الحكماء((6)) وذكره في المقام. والظاهر أنّه تمهيد لبيان ما يذكر بعد ذلك من الإشكال والجواب
ص: 97
بقوله(قدس سره): فإن قلت... إلخ، وهو خارج عن محل النزاع. مع أنّه لم يؤدّ حقّ الجواب وكأنّه أظهر العجز عنه في آخر المقال.((1))
وأمّا الإشكال المذكور في كلامه فهو الإشكال المعروف عن الخيّام((2)) وغيره.
وقد أجاب عنه المحقّق الطوسي(رحمه الله) بأنّ العلم تابع للمعلوم ولا يكون المعلوم تابعاً للعلم.((3))
ص: 98
وفي هذا الجواب نظر، بل ظاهره واضح الفساد؛ لأنّ العلم على قسمين:
علم فعليّ، وهو الّذي يتعلّق بما أراد الفاعل فعله، وهذا العلم ليس تابعاً للمعلوم لأنّه لا يكون موجوداً قبله.
وعلم انفعالي: وهو الّذي يكون تابعاً للمعلوم، لأنّه لا يتعلّق بالمعلوم إلّا بعد وجوده.
وعلمه تعالى إنّما يكون من قبيل الأوّل، وأمّا الثاني فمحال في حقّه تعالى.
والتحقيق في بيان مراده(قدس سره): أنّ علمه تعالى بالنظام الأتمّ تعلّق بما أنّها مترتّبة بعضها على بعض وبما أنّ بعضها علل و بعضها معلولات، ومن الواضح أنّ ذلك الترتّب والعلّية، سواء كان إعدادياً أو ما به يكون الشيء موجوداً، ليس حاصلاً بجعله تعالى، بل هو حاصل بذاته وبالنظر إلى ماهيته المجعولة، فالصادر عنه تعالى بإيجاده هي الموجودات، والعلم بالترتب والعلّية المذكورة بين هذه الموجودات - المعلومة - يكون شبيهاً بالانفعال، ومن جملة تلك المعلومات فعل المكلّف الّذي يكون معلولاً لاختياره بأن يصدر الفعل عنه بترجيحه جانب الوجود أو العدم بعد كون فعله وتركه للمكلّف وميله إليهما على السواء.
وما ذكرناه هو الملاك في اختيارية الأفعال وصحّة المؤاخذة والعقوبة وحسن الثواب، لا ما ذهب إليه المحقّق الخراساني(قدس سره) من كون ملاكها مسبَّبية الفعل عن الإرادة وصدوره بها، لأنّ الحيوان أيضاً يصير على هذا المبنى مختاراً ومستعدّاً لتوجيه التكليف إليه.
وبالجملة: خلق الإنسان ذا أميالٍ مختلفة وغرائز متباينة، لأنّ النفس الإنسانية متكوّنة من الرقائق المتضادّة، فلها ميولٌ حسب ما تقتضيه تلك الرقائق، فلا محالة يكون للإنسان بالنسبة إلى فعل کلّ شيء وتركه ميل إلى أحدهما حسب تلك الميول.
ومنحه الله تعالى القوّة العقلية لتمييز الصلاح والفساد، وبَعَث الأنبياء(علیهم السلام) ليعاونوا
ص: 99
العقل على ذلك وعلى إتيان الصالحات وترك السيّئات، فلا يصدر عنه فعل ولا ترك إلّا بعد ترجيحه أحد الطرفين، وهذا هو معنى الاختيار.
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى: ﴿إنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَليهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾.((1))
الأمشاج: جمع المشج، ومعناه المختلط. فالمعنى والله العالم: أنّه تعالى خلق الإنسان من مختلطات، أجزاؤها أيضاً مختلطة، وهذا الاختلاط إشارة إلى تلك الرقائق. كما أنّ الظاهر من الآية أنّ المراد بالنطفة نطفته الروحانية لا الجسمانية.((2)) وهذا الاختلاف والاختلاط صار سبباً لاختلاف الميول ثم الاختيار وترجيح بعضها على بعض.
إذا عرفت ذلك كلّه تعرف أنّ علمه تعالى بصدور الفعل عن العبد باختياره لا يقلّب الفعل عن كونه اختياريا. لأنّ هذا العلم يكون لا محالة شبه الانفعال وتابعاً للمعلوم؛ إذ العلّية والمعلولية من ذاتيّات العلل والمعلولات.((3))
ص: 100
ص: 101
بعدما ظهر لك في الجهة الثالثة: أنّ حقيقة الطلب عبارة عن وجود إنشائيّ اعتباريّ موطنه عالم الاعتبار، وينتزع من الجمل الإنشائية البعثية، فليعلم: أنّ الطلب على قسمين: إلزامي إيجابي، وندبي استحبابي.واللازم بيان ما به يمتاز کلّ واحد منهما عن الآخر.
فنقول: إنّ امتياز الأشياء بعضها عن بعض تارة: يكون بتمام الذات من غير أن يفرض بينهما جزء مشترك.
واُخرى: ببعضها، وهذا في الحقائق المشتركة في الجنس الممتازة بالفصل الّذي هو جزء الذات.
وثالثة: يكون الامتياز بالمنضمّات والعوارض.
ورابعة: يحصل بالزيادة والنقصان، مثل: الخطّين المتمايزين بالطول والقصر.
وخامسة: يتحقّق الامتياز بالشدّة والضعف، كامتياز بياض العاج عن بياض الثلج. وفي هذين الأخيرين يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ امتياز الأمر الوجوبي عن الاستحبابي ليس من قبيل القسم الأوّل ولا الثاني. أمّا الأوّل فواضح.
ص: 102
وأمّا الثاني، فلأنّ الامتياز بجزء الذات لا يتحقّق إلّا إذا كان فصل الوجوب هو المنع من الترك، وفصل الاستحباب هو الإذن في الترك، كما هو المشهور بين القدماء. والحال أنّه ليس كذلك؛ لأنّ المنع من الترك في الأمر الوجوبي والإذن فيه في الندبي لا يكون جزء الذات وداخلاً فيها كدخول الفصل المقوّم في النوع، بل المنع من الترك لا يكون في الحقيقة إلّا طلب ترك الترك، وترك الترك نفس الفعل لا الجزء المميّز له.
كما أنّه ليس الامتياز أيضاً من قبيل القسم الثالث والرابع. وإنّما الظاهر كونه من قبيل القسم الخامس، إذ الطلب الإنشائي يكون كالبعث الخارجي المباشري فكما أنّ الطالب في الطلب المباشري قد يكون شديد البعث بحيث يجرّ المبعوث نحو المطلوب، وقد لا يكون بهذا الحدّ، كذلك في الطلب الإنشائي، فيكون الامتياز بين الوجوب والندب بالشدّة والضعف.
وليس معنى ذلك كون الطلب الإنشائي من المقولات المشكّكة حتى يقال بأنّ الأمر الاعتباري ليس مقولاً بالتشكيك، بل بمعنى أنّ إنشاء الطلب تارة يكون مقارناً لاُمور تدلّ على تأكّده، واُخرى يكون مقارناً لاُمور تدلّ على عدم تأكّده. فالطلب الندبي هو الطلب المقارن مع الإذن في الترك، والطلب الخالي عن ذلك أو المقارن مع اُمور تؤكّد الطلب هو الطلب الإيجابي.
فعلى هذا يكون الأمر حقيقة في الطلب، وأمّا الوجوب فإنّما يستفاد من عدم مقارنة الأمر مع القرينة الدالّة على الندب. فما هو الملاك وتمام الموضوع لاستحقاق العقاب وصحّة مؤاخذة المولى عبده، نفس إنشاء الطلب مع عدم الإذن في الترك ولو احتملنا إذنه في الترك.
ويمكن أن يقال بأنّ امتياز الوجوب والندب إنّما يكون في مبدئهما، وما هو علّة للطلب الإنشائي وهي الإرادة النفسانية، فإنّها تارة تكون متأكّدة بحيث لا يرضى
ص: 103
بترك مراده، وتارة لا تكون كذلك، فإذا كانت متأكدة يكون الطلب الإنشائي الناشئ منها إيجابياً وإلّا كان ندبيّاً.
فعلى هذا يكون الطلب الإنشائي غير المقرون بالإذن في الترك كاشفاً عن هذه الإرادة المتأكّدة وطلباً إلزامياً.
ثم إنّه ربما يظهر من كلام بعضهم: أنّ الفصل المميّز بين الوجوب والاستحباب إنّما هو صحّة المؤاخذة على المخالفة في الوجوب، وعدمها في الندب.
كما يظهر من بعض آخر أنّ فصل الوجوب هو عدم رضا المولى بترك الواجب، وفصل الندب رضاه على ذلك.
ولا يخفى ما فيهما.
أمّا الأوّل، فلأنّ صحّة المؤاخذة وعدمها من الآثار العقلية للأمر الوجوبي والاستحبابي، الّتي لا تكون إلّا بعد تحصّل الأمر الوجوبي في الوجوب والندبي في الندب، فلا يعقل أخذها في تحصّل الوجوب وعدمها في تحصّل الندب؛ لأنّ الفصل إنّما يكون محصّل الجنس ومقوّم النوع.
وأمّا الثاني، فلأنّ عدم الرضا على ترك الفعل أمر قلبي نفساني لا يمكن أن يكون فصلاً مقوّماً لما يوجد في الرتبة المتأخّرة عنه في عالم الاعتبار، وكذلك الرضا على الفعل.
وقد ظهر ممّا ذكرناه: أنّ دلالة الجمل الإنشائية - فيما تكون خالية عن الإذن في الترك - على الوجوب إنّما تكون بالدلالة العقلية؛ لأنّ المتكلّم الحكيم إذا قال: «اضرب زيداً» أو «أمرتك بكذا» فكلامه هذا من حيث إنّه فعل من أفعاله یدلّ على صدوره منه عن الاختيار والقصد، وأنّ صدوره عنه لا يكون لغواً ولا هزلاً بل لأجل إفادة فائدة. ومن حيث إنّه لفظ تکلّم به یدلّ على أنّه تکلّم به لإفادة المعنى الموضوع له لا لإفادة مطلب آخر، وهذا الإنشاء الخالي من الإذن في الترك من حيث إنّه فعل صدر
ص: 104
من الحكيم یدلّ على الوجوب، إمّا من جهة كونه مقارناً مع أمریدلّ على تأكّد طلب المولى بناءً على المبنى الأوّل، أو من جهة كونه دالاً على وجود الإرادة المتأكّدة في نفسه على المبنى الثاني.
ومن هنا ظهر عدم صحّة ما أفاده المحقّق الخراساني(رحمه الله)((1)) من دلالة الأمر وضعاً أو إنصرافاً على الطلب الإنشائي المقيّد بالإرادة المتأكّدة؛ إذ فيه مضافاً إلى ما ذكر أنّ الطلب الإنشائي لا يمكن أن يكون مقيّداً بالإرادة الّتي هي من الكيفيّات النفسانية، مع أنّ الطلب الإنشائي إنّما يكون معلولاً للإرادة، فكيف يقيّد المعلول بعلّته؟
ثم إنّ ما ذكرناه إلى هنا إنّما يكون مبنيّاً على صحّة تقسيم الطلب إلى الإيجاب والندب، وأمّا لو قلنا بعدم صحّة هذا التقسيم، وأنّ الاستحباب والإذن في الترك تنافي مع البعث والتحريك والطلب، وأنّ مقتضى المولويّة الطلب على سبيل الإلزام، فلا يبقى مجال لهذه الأبحاث.
وقد اختار ذلك المحقّق القمّي(قدس سره)،((2)) فإنّه ذهب إلى مباينة الندب مع الوجوب وعدم كونهما من سنخ واحد. وأنّ الأوامر الندبيّة كلّها إنّما تكون للإرشاد؛ لأنّ الندب منافٍ للطلب والبعث ومقتضى المولوية.
وربما كان مختاره هذا غير بعيد عن الصواب.
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى مادّة الأمر سواء اُنشئ بالألفاظ أو الأفعال من غير دخل خصوصية لفظ من الألفاظ أو فعل من الأفعال. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال، وهو حسبي ونعم الوكيل.
ص: 105
الاُولى: اختلاف صيغ الأمر
الصيغ الّتي بها يتحقّق الطلب بحيث يصحّ بعد التكلّم أن يقال: «طلب المتکلّم» وإن كانت متّفقة في أصل تحقّق الطلب بها، لكن يمكن القول بالفرق بينها. ففرق بين قول المولى لعبده: أطلب منك إكرام العلماء أو آمرك بإكرامهم، وبين قوله: أكرم العلماء؛ فإنّ مفهوم الطلب في الأوّل يكون متصوّراً عنده ويتوجّه إليه المتکلّم عند التكلّم، وهذا بخلافه في الثاني فإنّه ليس للآمر توجّه إلّا إلى المطلوب وهو إكرام العلماء، فكأنّه لم يكن الطلب متصوّراً عنده حين إلقاء اللفظ.
ومن هذه الجهة ذهب بعض أساتذتنا إلى أنّ صيغة إفعل وما في معناها موضوعة لمجرد انتساب الفعل. ولكنه لا يخفى ما فيه؛ لأنّا نرى أنّ المتکلّم إذا قال: إضرب أو اُنصر، يقال في العرف: طلب الضرب أو النصر.
هذا، ويمكن أن يقال: إنّ الإنسان تارة: يتوجّه إلى الشيء توجّه من يطلبه، واُخرى: توجّه من يتصوّره، وثالثة: توجّه من يصدّقه، ولابدّ أن يكون لفظ إضرب مثلاً مستعملاً وموضوعاً للضرب الّذي توجّه إليه المتكلّم توجّه من يطلبه، إذ لا يمكن أن يكون موضوعاً لتصوّر أو تصديق نسبة الضرب إلى المخاطب، لأنّهما أجنبيان عن مفاد هذه الصيغ الإنشائية، فتدبّر.
الثانية: كثرة استعمال الأمر في الندب
قال صاحب المعالم(قدس سره): الثانية: «يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة(علیهم السلام) أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعاً في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي،
ص: 106
فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمرٍ بمجرّد ورود الأمر به منهم(علیهم السلام)».((1))
وقد أجاب عنه في الكفاية بوجوه:
الأوّل: إنّ كثرة استعمال صيغة الأمر في الندب في الكتاب والسنّة غير موجب لنقلها إليه أو حملها عليه لكثرة استعمالها في الوجوب أيضاً.
الثاني: إنّه وإن كثر استعمالها فيه إلّا أنّه مع القرينة المصحوبة، وذلك وإن كان موجباً لشدّة اُنس الذهن مع المعنى المجازي إلّا أنّ مجرّد الاُنس وتوجّه الذهن إلى المعنى المجازي بمعونة القرينة لا يكون موجباً لصيرورة اللفظ مجازاً مشهوراً حتى يترتّب أثره وهو الترجيح أو التوقّف.
الثالث: النقض بكثرة استعمال العامّ في الخاصّ حتى قيل: «ما من عامّ إلّا وقد خصّ» ومع ذلك لم ينثلم بها ظهوره في العموم بل يحمل على العموم ما لم تقم قرينة على الخصوص.((2))
وفيما أفاده في مقام الجواب نظر:
ففي الأوّل: أنّ صاحب المعالم(قدس سره) ادّعى الكثرة في جميع الأخبار المروية عنهم(علیهم السلام) لا خصوص السنّة المصطلحة في المرويات عن النبي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) حتى يقال بكثرة استعمالها في الوجوب فيها أيضاً. وادّعاء كثرة استعمالها في الوجوب في جميع الأخبار في مقابل كثرته في الندب مُجازفة جدّاً.
وفي الثاني: أنّه لو قلنا بأنّ الدالّ على المعنى المجازي هو اللفظ والقرينة معاً صحّ ما أفاده في الجواب. أمّا لو قلنا بأنّ الدالّ على المعنى المجازي هو نفس اللفظ، والقرينة إنّما تدلّ على إرادة المعنى المجازي منه كما هو الحقّ، فلا يتمّ ما أفاده، ففي مثل قولنا:
ص: 107
رأيت أسداً يرمي يكون المستعمل في الرجل الشجاع هو الأسد وأمّا «يرمي» فهي قرينة على إرادة المعنى المجازي من اللفظ.
وفي الثالث: أنّ العامّ كما هو التحقيق ومختاره أيضاً،((1)) لا يستعمل إلّا في العموم، والمخصّص إنّما یدلّ على تعلّق الإرادة الجدّية بالخاصّ.
هذا مضافاً إلى أنّ استعمال العامّ في الخاصّ وإن كان كثيراً إلّا أنّه ليس بالنسبة إلى معنى مجازيّ واحد بل يكون بالنسبة إلى معانٍ مجازية متعدّدة، فلا يكون استعماله بالنسبة إلى کلّ واحد من هذه المعاني كثيراً، وأين هذا من استعمال صيغة الأمر وإرادة الندب الّذي لا يكون إلّا معنى مجازياً واحداً، فكثرة الاستعمال فيه توجب اُنس الذهن بخلاف المقيس عليه.
هذا كلّه بناءً على المسلك المشهور وأنّ الأمر حقيقة في الوجوب.
وأمّا بناءً على المختار من كون الأمر حقيقة في مطلق الطلب وأنّ الوجوب إنّما يستفاد من عدم اقتران الأمر بقرينة على الترخيص بخلاف الندب، أو من جهة أنّ الوجوب عبارة عن الإرادة الأكيدة فخلوّ الأمر عن القرينة الدالّة على الندب يكون كاشفاً عنها بخلاف الندب، فلا يبقى مجال لهذه التفصيلات.
نكتة: في الأوامر ونواهي المعصومين(علیهم السلام): وهاهنا نكتة لا يخلو ذكرها عن فائدة في الفقه، وهي: أنّ الأوامر والنواهي الصادرة عن النبيّ والأئمّة - صلوات الله عليهم أجمعين - ليست كلّها مولوية، بل تارة تصدر عنهم بما أنّ لهم الولاية والسلطنة على الناس: وهذه كالأوامر والنواهي النبوية الصادرة في الغزوات المرتبطة بالجهاد من تعيين وظائف المجاهدين ونحو ذلك، وكالأوامر والنواهي العلوية في حرب الجمل وصفّين وغيرهما.
ص: 108
وتارة اُخرى: تصدر عنهم بما أنّهم مبلّغو الأحكام وعالمون بالتكاليف الدينية. وهذا القسم لم يصدر عنهم إلّا لمجرّد الإرشاد، كأوامر الفقهاء والوعّاظ ونواهيهم. فقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بعد سؤال السائل عن من شكّ في الثلاث والأربع: «يبني على الأربع» مثلاً، لا یدلّ إلّا على الإرشاد، ومخالفته لا تعدّ معصية ومخالفة للإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ). نعم، تكون معصية لله تعالى إذا كان المُرشَد إليه واجباً.
وعلى هذا البناء وفرض دلالة الإرشاد على مطلوبية المُرشَد إليه، تارة: يكون الأمر خالياً عن القرائن الدالّة على كون المُرشَد إليه ندباً فيحكم بوجوب المُرشَد إليه، واُخرى: لا يكون كذلك فيحكم باستحبابه.
ومن ذلك يظهر فساد ما ذكره صاحب المعالم(قدس سره) من كثرة استعمال الصيغة في كلام الأئمّة(علیهم السلام) في الندب؛ لأنّ الأوامر الصادرة عنهم إنّما استعملت في جميع الموارد - إلّا موارد خاصّة - في الإرشاد لا المولوية من الندب والوجوب.((1))
ثم إنّه قد ظهر ممّا ذكر حال بعض المباحث المذكورة في الكفاية،((2)) وإنّما لم نتعرّض لذكرها احترازاً من الإطالة، وهي كالبحث في أنّ الجمل الخبرية الّتي تكون في مقام الإنشاء هل تفيد الوجوب أو لا؟ فبأيّ لفظ اُنشئ الطلب يكون حاله حال الأمر من غير فرق بين الجمل الإنشائية والإخبارية.
ص: 109
إعلم: أنّ المحقّق الخراساني(رحمه الله) لم يجعل لبيان حقيقة الواجب التعبّدي والتوصّلي مبحثاً يخصّه، بل ذكر ذلك في المبحث الخامس من الفصل الثاني. وجعل البحث عن بيان ماهيّتها من مقدّمات التحقيق في أنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّلياً فيجزي إتيانه مطلقاً ولو بدون قصد القربة، أو لا؟ وأنّه لابدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته وتوصّليته إلى الأصل، والحال أنّ أصل البحث من مهمّات مباحث الأوامر، واللازم طرحه مستقلّا ثم طرح تفريعاته. وكيف كان، فالكلام - تبعاً لترتيب الكفاية - يقع في اُمور:
الأمر الأوّل: تنقسم الواجبات بل مطلق ما كان مأموراً به إلى التعبّدي والتوصّلي، والأوّل كالصلاة والصوم والحجّ وغيرها، والثاني كغسل الثوب والبدن ودفن الميّت وما يكون من هذا القبيل.
الأمر الثاني: إنّ المأمور به التعبّدي عبارة عن: ما يعتبر في حصول الغرض منه إتيانه لله تعالى. والتوصّلي ما لا يعتبر فيه ذلك، بل يحصل الغرض بمجرد تحقّقه وحصوله في الخارج وبأيّ وجه اتّفق ولو لم يكن حصوله بقصد التقرّب إلى الله تعالى، بأن كان بقصد الرئاء مثلاً أو بأيّ داعٍ آخر، أو حصل من غير قصد واختيار.
لا يقال: يلزم من ذلك تعلّق الأمر في التوصّليات بما هو أعم من كونه بالاختيار، ومحذوره لا يقلّ من محذور الأمر بما هو خارج عن الاختيار رأساً.
لأنّه يقال: إنّ الآمر تارة يأمر العبد ويصير أمره سبباً لإيجاد الداعي وإرادة الفعل في العبد من غير أن يكون لإرادته دخل في حصول غرض الآمر من تحقّق الفعل، واُخرى يأمره لإيجاد إرادة الفعل في العبد وصدور الفعل عن تلك الإرادة بأن يكون الفعل معلولاً لإرادته فلا يحصل غرض الآمر إلّا بصدور الفعل عن إرادة العبد؛ والواجب
ص: 110
التوصّلي إنّما يكون من القسم الأوّل، حيث يكفي مجرّد تحقّقه من غير دخل لإرادة العبد واختياره في حصول الغرض، ويسقط الأمر بتحقّق المأمور به ولو عن غير قصد واختيار، ولا يلزم منه المحذور المذكور، لأنّ الأمر يتعلّق بما هو مختار العبد لا أعمّ منه ولكنّه يسقط ولو بوقوع الفعل من غير اختيار، لأنّ غرضه قد حصل. فأثر الأمر في التوصّلي إنّما هو إيجاد الداعي في العبد من غير أن يكون لهذا الداعي دخل في الغرض.
الأمر الثالث: لا يعتبر في حصول التعبّد إتيان الفعل بداعي الأمر، بل إذا أتى به بأيّ داعٍ كان مناسباً لشأن المولى اعتناءً بشأنه واحتراماً له يحصل التعبّد ولو لم يتعلّق به أمر المولى.
نعم، إذا شكّ في أنّ هذا مناسبٌ لشأن المولى ومقامه أم لا؟ لابدّ لاستكشاف ذلك من الأمر به.
الأمر الرابع: لا يخفى عليك: أنّنا لم نعثر في كلمات السابقين على الشيخ الأنصاري(رحمه الله) القول بعدم إمكان أخذ قصد التقرّب والامتثال في متعلّق الأمر، بل الظاهر أنّ مذهبهم كون قصد الامتثال من ضمن كيفيّات المأمور به. والشيخ(قدس سره) أوّل من ذهب إلى عدم إمكانه، وفرّع عليه عدم جواز التمسّك بالإطلاق في صورة الشكّ لإثبات توصّلية المأمور به.((1))
وقد قرّر وجه هذا الكلام - الّذي أرسله تلامذة الشيخ ومن تأخّر عنهم إرسال المسلّمات - في التقريرات بما حاصله راجع إلى أنّ تخصّص الفعل بخصوصية إتيانه بقصد الامتثال واتّصافه بتلك الخصوصية إنّما يكون من الاُمور المتأخّرة عن الأمر ومن الانقسامات اللاحقة للحكم، فكيف يعقل أخذه في موضوع الحكم؟
وقد ذكروا في بيان ذلك وجوهاً بعضها يرجع إلى وقوع المحال في ناحية الأمر وأنّه
ص: 111
لا يعقل الأمر مع قصد الامتثال في المأمور به - شرطاً كان أو شطراً - ؛ وبعضها يرجع إلى امتناعه في ناحية الإتيان والامتثال.
ذكروا لبيان وقوع المحال في ناحية الأمر و كونه تكليفاً محالاً وجوهاً:((1))
أحدها: أنّه لا شكّ في أنّ نسبة الحكم إلى الموضوع كنسبة العرض إلى المعروض، والصفة إلى الموصوف؛ فكما لا يمكن أخذ العرض في المعروض والصفة في الموصوف للزوم الدور وتقدّم الشيء على نفسه، كذلك لا يمكن أخذ قصد الأمر في موضوع الحكم؛ لأنّ الحكم وقصد امتثاله متوقّفان على الموضوع ومتأخّران عنه، فلو فرض أخذ قصد امتثاله في الموضوع يلزم تقدّم هذا المتأخّر وصيرورة المتوقّف موقوفاً عليه، وليس هذا إلّا تقدّم الشيء على نفسه، وهو الدور المحال.
ثانيها: أنّ من الواضح اشتراط التكليف بقدرة المكلّف وعدم تعلّق الأمر إلّا بالمقدور، فلو أخذنا قصد الامتثال في متعلّقه يلزم عدم مقدوريته، لأنّ القدرة عليه تتوقّف على الأمر والأمر متوقّف على كونه مقدوراً، فيلزم الدور.((2))
ثالثها: ما أفاده بعض أساتيذنا: من لزوم اجتماع اللحاظين؛ لأنّ قصد الأمر لو كان من الكيفيّات المأخوذة في المأمور به يلزم بالنسبة إلى الآمر لحاظه آليّاً واستقلاليّاً، لأنّ الأمر بالصلاة المقيّدة بقصد الأمر يكون ملحوظا آليّاً ومندكّاً في لحاظه استقلاليّاً قيداً للصلاة المأمور بها فليزم المحال واجتماع اللحاظين المتنافيين.
ص: 112
فاعلم: أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني(قدس سره) من لزوم الإشكال والمحال في ناحية الامتثال وجوه:
الأوّل: أنّ داعويّة الأمر لا تكون إلّا إلى عمل منطبق للمأمور به، فإذا كان المأمور به مقيّداً بالداعويّة يلزم الدور، لأنّ الداعويّة تتوقّف على انطباق العمل على المأمور به، والانطباق يتوقّف على الداعويّة.
الثاني: إنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه، والمفروض أنّه ليس ذات الفعل، بل هو ذات الفعل بداعي الأمر، وحينئذٍ ننقل الكلام إلى الأمر الثاني وأنّ متعلّقه ليس ذات الفعل، بل ذات الفعل بداعي الأمر - حسب الفرض - وهكذا الكلام في الأمر الثالث، وهلمّ جرّا تتسلل الأوامر إلى غير النهاية.
وقد أفاد صاحب الكفاية(قدس سره) هذا الوجه والوجه السابق في مجلس درسه.
الثالث: ما يظهر من الكفاية((1)) من عدم إمكان الإتيان بذات الفعل بداعي الأمر؛ لأنّ الأمر - حسب الفرض - متعلّق بها مقيّدة بداعي الأمر ولا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى متعلّقه لا إلى غيره أي ذات الفعل. وبعبارة اُخرى امتثال الأمر بالصلاة المقيّدة بقصد الأمر بها دون ذاتها بقصد الأمر موقوف على الأمر بذاتها المفقود هنا، والأمر بها مقيّدة بقصد الأمر لا يمكن امتثاله لأنّه لا يدعو إلّا إلى ما تعلّق به دون غيره أي ذات الصلاة، فتدبّر.
توضيح عبارات الكفاية: وحيث إنّ عبارات الكفاية في هذا المقام في غاية الاختصار، فلا بأس بتوضيحها وبيان المراد منها.
ص: 113
فهو(قدس سره) بعد الإشارة إلى استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّقه قال: «وتوهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر... إلخ».
لعلّ المتوهّم يريد أوّلاً دفع الإشكال الثالث من ناحية الأمر((1)) بأنّه يمكن تصوّر الأمر بالمقيّد ولحاظ الأمر آليّاً واستقلاليّاً، لکنّه لا بلحاظ واحد ولا في رتبة واحدة، بل بلحاظين وفي رتبتين.
ولم يذكر دليل إمكان تصوّر الآمر لها((2)) مقيّدة كما أنّه لم يذكر أصل الإشكال.
وثانياّ دفع الإشكال الثاني من ناحية الأمر (من لزوم الدور وتوقّف الأمر على القدرة والقدرة على الأمر) بأنّ المعتبر من القدرة المعتبرة عقلاً في صحّة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر.
وهذا التوهّم واضح الفساد، ضرورة أنّه وإن كان تصوّرها كذلك بمكان من الإمكان ويجاب به عن الإشكال باجتماع اللحاظين، إلّا أنّه لا يدفع إشكال الدور، لأنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها؛ لعدم الأمر بها، فإنّ الأمر - حسب الفرض - تعلّق بها مقيّدة بداعي الآمر ولا يكاد يدعو الآمر إلّا إلى ما تعلّق به لا إلى غيره.
إن قلت: نعم، ولكن نفس الصلاة أيضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقيّدة.
وذلك بتصوير الأمر الانحلالي لذات الفعل؛ لأنّ المأمور به بالتحليل العقلاني ينحلّ إلى المقيّد والقيد.
ص: 114
قلت: كلّا! وسيأتي في باب مقدّمة الواجب عدم اتّصاف الجزء التحليلي العقلي بالوجوب، فذات المقيّد مجرّدة عن القيد لا تكون مأموراً بها، وليس في الخارج إلّا وجوداً واحداً واجباً بالوجوب النفسي.
إن قلت: سلّمنا ذلك، لكنّنا نقول بأخذ قصد الامتثال شطراً وجزءً لا شرطاً وقيداً، فعليه يكون نفس الفعل الّذي تعلّق به الوجوب مع قصد الامتثال متعلّقاً للوجوب، لأنّ المرکّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر، أي لا بشرط الاجتماع ولا بشرط عدمه، فكما يتعلّق الأمر بمجموع الأجزاء، كذلك يتعلّق بکلّ واحد من الأجزاء، فيكون تعلّقه بکلّ بعين تعلّقه بالكلّ، فيصحّ إتيان الفعل بداعي ذلك الوجوب ضرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبها، فالجزء الّذي هو ذات الفعل يؤتى به بقصد الامتثال، والجزء الآخر الّذي هو عبارة عن قصد الامتثال يتحقّق بتحقّق الجزء الّذي هو ذات الفعل الّذي يؤتى به بقصد الامتثال.
قلت: لا يمكن تصوير صحّة ذلك في المقام وإن سلمنا صحّته في غيره، لأنّه يلزم من ذلك تعلّق الأمر بأمر غير اختياري، فإنّ الفرض كون داعي الأمر جزاً للمأمور به لا شرطاً، فيكون القصد أيضاً مأموراً به كنفس الفعل، والحال أنّ قصد الأمر ليس إلّا إرادة خاصّة، وملاك اختيارية الفعل صدوره عن الإرادة، وأمّا الإرادة نفسها فلا تكون عن إرادة اُخرى وإلّا لتسلسلت فلا تكون اختيارية.
هذا مضافاً إلى أنّه لا يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه مستقلاً ومن غير أن يكون في ضمن الكلّ، وإنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيان الجميع بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره، لأنّه يلزم منه علّية الشيء لنفسه ومحرّكيته إلى محرّكية نفسه.
إنتهى ما أردنا ذكره لإيضاح بعض عبارات الكفاية في المقام. ولنرجع إلى ما كنّا فيه وتحقيق الحقّ في المقام فنقول:
ص: 115
ربما يتوهّم((1)) الفرق بين أخذ قصد الأمر في المأمور به وبين غيره من الدواعي كحسن الفعل أو مصلحته أو محبوبيته عند المولى وغير ذلك، فترد الإشكالات المذكورة عند قصد الأمر دون غيره من الدواعي، فلا مانع من أخذها في المأمور به.
والحقّ عدم الفرق بين قصد الأمر وغيره في ورود إشكال الدور والتسلسل وغيرهما؛ لأنّ قصد الحسن والمصلحة أيضاً متوقّف على كون الفعل حسناً ومشتملاً على المصلحة في الخارج، وكونه كذلك متوقّف على قصد الحسن والمصلحة عند الإتيان، وإلّا لم يكن الفعل حسنا ولا ذا مصلحة. وقس على هذا البيان تقرير التسلسل وغيره من الإشكالات.
إنّ الإشكالات الراجعة إلى لزوم المحال في ناحية الأمر، كلّها بعيدة عن الصواب.
أمّا الإشكال الأوّل، ففيه: أنّ الحكم إنّما يكون متوقّفاً على الوجود الذهني للموضوع لا الخارجي منه، وأمّا الموضوع فهو بوجوده الخارجي متوقّف على الحكم، فلا دور.
وأمّا الإشكال الثاني، ففيه: أنّ القدرة الّتي هي ملاك صحّة التكليف والأمر إنّما هي القدرة على إتيان المأمور به في ظرف الامتثال والإتيان لا قبله، فقدرة المكلّف قبل زمان الامتثال وظرف الإتيان لا تكون من قبيل أجزاء العلّة بالنسبة إلى التكليف حتى يقال بلزوم حصولها عند تعلّق الحكم بالموضوع.
ص: 116
فالحكم متوقّف على لحاظ قدرة المكلّف عند الامتثال ولا شكّ في أنّه يصير قادراً حين الامتثال ولو تتوقّف هذه القدرة على الأمر، فلا دور أصلاً.((1))
وأمّا الإشكال الثالث، ففيه: أنّ ما هو المحال هو لحاظ شيء آليّاً واستقلاليّاً بلحاظ واحد وفي آنٍ واحد، وأمّا لحاظه تارة آليّاً واُخرى استقلاليّاً جائز بالضرورة، فيلاحظ الأمر تارة استقلاليّاً آن تصوّر الموضوع، واُخرى آليّاً حين تعلّق الأمر به.
هذا تمام الكلام في الجواب عن الإشكالات الراجعة إلى لزوم المحال في ناحية الأمر.
وإنّما المهمّ الجواب و التفصّي عن الإشكالات الراجعة إلى لزوم المحال في ناحية الامتثال. وقد أفادوا في مقام التفصّي وجوهاً غير خالية عن الإشكال.
أحدها: الالتزام بتعدّد الأمر بأن يتوصّل الآمر إلى غرضه بأمرين أحدهما يتعلّق بذات الفعل، والآخر بإتيانه بداعي الأمر. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري(قدس سره).((2))
وأجاب عنه في الكفاية((3)) أوّلاً: بمنع الصغرى، لأنّا نقطع بأنّه ليس في العبادات إلّا أمر واحد.
وثانياً: بأنّ الأمر الأوّل لو كان يسقط بمجرّد الإتيان بذات الفعل مجرّداً عن قصد الامتثال، فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني؛ لانتفاء موضوعه رأساً، فلا يتوصّل الآمر بالأمر الثاني إلى غرضه. وإن لم يكد يسقط، فليس له وجه إلّا عدم حصول غرضه بذلك، فلا وجه حينئذٍ للأمر الثاني (ولا التشبّث بحيلة تعدّد الأمر)؛ لاستقلال العقل بلزوم إتيان المأمور به بنحو يحصل غرض الآمر به.
ص: 117
ثانيها: ما يستفاد من بيان الكفاية في ضمن الجواب المذكور من أنّ المقصود إتيان الفعل بداعي الأمر إلّا أنّ المولى لمّا لم يتمكّن من أخذ ذلك في الأمر جعل متعلّق أمره أعمّ ممّا هو محصّل لغرضه وغيره، ثم إنّ العقل بعد ذلك يحكم بلزوم موافقته على نحو يوجب سقوط الأمر وحصول الغرض.
وفيه: أنّه يلزم من ذلك أن يكون الأمر بذات الفعل صورياً محضاً من غير أن يكون محصّلاً لغرض المولى، والحال أنّ الظاهر من الأمر بها كونه حقيقياً.
ثالثها: ما أفاده بعض الأجلّة من المعاصرين(قدس سره)((1)) وهو الفعل الواقع في الخارج على قسمين: أحدهما ما ليس للقصد دخل في تحقّقه بل لو صدر من العاقل لصدق عليه عنوانه، والثاني ما يكون قوامه في الخارج بالقصد كالتعظيم والإهانة وأمثالهما. ولا إشكال في أنّ تعظيم من له أهلية ذلك بما هو أهل له وكذا شكره ومدحه بما يليق به حسن عقلاً ومقرّب بالذات بلا حاجة في تحقّق هذا القرب إلى وجود أمر بهذه العناوين.
نعم، قد يشكّ في أنّ التعظيم المناسب له أو المدح اللائق بشأنه يتحقّق بماذا؟ وقد يتخيّل كون عمل خاصّ تعظيماً له وأنّ القول الكذائي مدح له وفي الواقع ليس كذلك، بل ما اعتقده تعظيماً له يكون توهيناً له وما اعتقده مدحاً يكون ذمّاً بالنسبة إلى مقامه. والمكلّف لمّا لم يكن له طريق إلى استكشاف المناسب لمقام المولى تبارك وتعالى إلّا إعلامه تعالى، فلابدّ أن يعلّمه أوّلاً ما يتحقّق به تعظيمه ثم يأمره به، وليس هذا الأمر إلّا لتشخيص المناسب لمقامه تعالى من دون أن يكون قصده دخيلاً في تحقّق القرب حتى يلزم منه محذور الدور.
وفيه نظر: لأنّ الباعث على الاهتمام في تصحيح الأمر التعبّدي وجزئية قصد الأمر أو قيديّته وقوع الإجماع بل الضرورة عليه بين المسلمين خلفاً عن سلف، وإلّا فإنكاره
ص: 118
بالمرّة ليس بعسير، فالمقصود تصويره على نحو لا يزاحم ذلك الإجماع والضرورة، وهذا لا يتمّ بما ذكره(قدس سره)، فإنّه أنكر دخالة قصد التقرّب في العبادة رأساً، إذ المراد من إتيان الفعل بقصد التعظيم إن كان إتيانه بداعي كونه تعظيماً للمولى، فهذا وإن كان موجباً لصيرورة العمل عبادة، إلّا أنّه لا يرفع به إشكال الدور؛ لأنّ قصد كون الفعل تعظيماً للمولى موقوف على كون ذات الفعل تعظيماً له وكونها كذلك موقوف على قصد كونه تعظيماً له، وقد مرّ((1)) نظير هذا الإشكال في صورة قصد الملاك والمصلحة.
وأمّا إن كان مراده من إتيان الفعل بقصد التعظيم إنشاء التعظيم وإيجاده بالفعل من دون أن يقصد التقرّب به، فلازمه مضافاً إلى إنكار ما عليه الإجماع والضرورة من اعتبار قصد التقرّب، اجتماع ذلك مع الدواعي النفسانية كالرئاء وهضم الغذاء وغيرهما، وأن يكون قصد الرئاء وغيره غير منافٍ لإنشاء التعظيم الّذي فرض هنا عبادة، وهذا أيضاً مخالف للإجماع.((2))
ورابعها: ما أفاده المعاصر المذكور(قدس سره) أيضاً((3)) بأنّه من الممكن أن يكون المعتبر في العبادات إتيان الفعل خالياً عن سائر الدواعي ومستنداً إلى داعي الأمر، فالفعل المقيّد بعدم الدواعي النفسانية ووجود الداعي الإلهي وإن لم يكن قابلاً لتعلّق الأمر به بملاحظة جزئه الأخير ولزوم الدور، وأمّا من دون ضمّ الأخير فلا مانع منه.
وأمّا إشكاله بأنّ هذا الفعل من دون ملاحظة تمام قيوده الّتي منها الأخير لا يكاد
ص: 119
يتّصف بالمطلوبية، وكيف يمكن تعلّق الطلب بالفعل من دون ملاحظة تمام القيود الّتي يكون بها قوام المصلحة، فمندفع بأنّه قد يتعلّق الطلب بما ليس هو مطلوباً في حدّ ذاته، بل يراد منه حصول أمر آخر، والفعل المقيّد بعدم الدواعي النفسانية من هذا القبيل، فإنّه وإن لم يكن تمام المطلوب مفهوماً، إلّا أنّه لمّا لم يوجد في الخارج مصداق له إلّا بداعي الأمر - لعدم إمكان خلوّ الفاعل المختار عن کلّ داعٍ يصحّ تعلّق الطلب به - فهو يتّحد في الخارج مع ما هو مطلوب حقيقة. كما لو كان المطلوب الأصلي إكرام الإنسان، فلا شبهة في جواز الأمر بإكرام الناطق، لأنّه لا يوجد في الخارج مصداقٌ له إلّا متّحداً مع الإنسان الذي إكرامه مطلوب أصلي.
وليس هذا الأمر صورياً بل هو أمر حقيقيّ وطلب واقعيّ لأنّ متعلّقة متّحد في الخارج مع المطلوب الأصلي.
ولا يخفى: أنّ مثل هذه الأوامر الملحوظة فيها حال الغير تارة يكون للغير، واُخرى يكون غيرياً.
مثال الأوّل: الأمر بالغسل قبل الفجر لأجل الصوم، فإنّ الأمر متعلّق بالغسل قبل الأمر بالصوم، وليس هذا الأمر معلولاً لأمر آخر، إلّا أنّه يكون لمراعاة حصول الغير وهو الصوم في زمانه.
ومثال الثاني: الأوامر الغيرية الّتي تكون مسبّبة من الأوامر النفسية المتعلّقة بالعناوين المطلوبة نصّاً. وما نحن فيه من قبيل الأوّل، لأنّ الأمر بالفعل مقيّداً بعدم الدواعي النفسانية لا يكون تمام المطلوب النفسي، إلّا أنّه متّحد خارجاً مع ما هو تمام المطلوب ومحصّل لتمام الغرض فيكون أمراً للغير .
وهذا الجواب يشبه ما أجاب به صاحب الكفاية - وذكرناه في الوجه الثاني - في عدم تعلّق الأمر بتمام المطلوب، بل بما هو الأعمّ، ولكن لا يرد عليه ما أوردناه هناك، لأنّه
ص: 120
بنحو لا وجه لتوجّه الإشكال المذكور إليه. ولكن يورد عليه: بأنّه خلاف الظاهر من أدلّة العبادات، إذ ليس المعتبر فيها خلّوها عن الدواعي النفسانية وإتيانها بداعٍ إلهي، بل المعتبر فيها أمر بسيط وهو إتيانه بداعي الأمر الإلهي، فلا يستقيم ما ذكره في الجواب.
هذا تمام الكلام فيما أفادوه في مقام الجواب، وقد ظهر لك عدم ارتفاع الإشكال بواحد منها، فاللازم علينا التفصّي عن الإشكال على نحو صحيح.
وقبل الورود في المطلب لابدّ من تقديم مقدّمات:
اُولیها: أنّ دخل شيءٍ في المأمور به يتصوّر على ثلاثة أنحاء، الأوّل: كون ذلك الشيء جزءً للمأمور به بمعنى تركّبه منه ومن غيره. والثاني: كونه قيداً للمأمور به لا بمعنى كونه داخلاً فيه، بل بمعنى تقيّد المأمور به بذلك الشيء على نحو يكون القيد خارجاً وتقيّده به - على نحو المعنى الحرفي - داخلاً. والثالث: أن يكون المأمور به معنوناً بعنوان لا يمكن حصول ذلك العنوان له إلّا إذا كان معه هذا الشيء، وهذا في الحقيقة يكون شرطاً عقلياً لحصول المأمور به وممّا يتوقّف عليه انطباق ذلك العنوان على المأمور به.
ثانيتها: لا إشكال في أنّ الأمر كما يدعو إلى تمام متعلّقه يدعو أيضا إلى کلّ جزء من أجزائه وشرائطه ومقدّماته الخارجية، سواء قلنا بالملازمة في باب المقدّمة أم لا، لأنّه ولو لم نقل بالملازمة وترشّح الأمر بالمقدّمة من قبل الأمر بذيها لکنّه لم يناف أن يدعو الأمر إلى كلّ جزء من الأجزاء والشرائط والمقدّمات الخارجية، فإنّ المكلّف الذي يكون في مقام إطاعة مولاه وامتثال أوامره إذا رأى أنّ التكليف المتوجّه إليه مشروط بشرط، لا يتردّد في لزوم تحصيل ذلك الشرط. وهذا معنى دعوة الأمر واستدعائه کلّ جزء من الأجزاء والشرائط والمقدّمات الخارجية. هذا مضافاً إلى أنّه لو قلنا بالملازمة في باب المقدّمة لا
ص: 121
يكون الأمر المتوجّه إليها مستقلّا كسائر الأوامر، بل يكون فانياً ومندكّاً في الأمر بذيها، لأنّه لا هويّة للأمر الطريقي مستقلّا وبنفسه إلّا هويّة الأمر بذي الطريق، فيكون الأمر بالطريق والمقدّمة كلا أمر.
ومن هنا ظهر ضعف ما أفاده في الكفاية - في جواب الإيراد بأنّ نفس الصلاة أيضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقيّدة - بقوله: «قلت: كلاّ! لأنّ ذات المقيّد لا تكون مأموراً بها، فإنّ الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلاً... إلخ».
وقد عرفت وجه الضعف بأنّه لا حاجة إلى الأمر بل يكفي مجرّد كون الأمر داعياً إلى ذات المقيّد، لأنّ الأمر كما يكون داعياً إلى متعلّقه يكون داعياً إلى جميع مقدّماته وشرائطه أيضاً.
ولا يخفى عليك: أنّ ما أفاده بعد ذلك - في جواب الإشكال الّذي أورده على نفسه - أيضاً ضعيف جدّاً، فإنّه بعد ذكر الإيراد بقوله: «إن قلت: نعم، لکنّه إذا اُخذ قصد الامتثال شرطاً، وأمّا إذا اُخذ شطراً فلامحالة نفس الفعل الّذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلّقاً للوجوب، إذ المرکّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر، ويكون تعلّقه بکلٍّ بعين تعلّقه بالكلّ، ويصحّ أن يؤتى به بداعي ذلك الوجوب ضرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه». أفاد في مقام الجواب بما لفظه: «قلت: مع امتناع اعتباره كذلك فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياريّ، فإنّ الفعل وإن كان بالإرادة اختيارياً إلّا أنّ إرادته حيث لا تكون بإرادة اُخرى وإلّا لتسلسلت ليست باختيارية، كما لايخفى».
وفيه أوّلاً: أنّ الإرادة تكون اختيارية، لأنّ اختيارية کلّ فعل بها وهي بنفسها اختيارية، فلا يلزم التسلسل.
وثانياً: لو كانت الإرادة غير اختيارية فلا يمكن دخلها في الغرض وحكم
ص: 122
العقل بوجوبها لتحصيل الغرض، مع أنّ صاحب الکفایة(قدس سره) ذهب إلى دخلها في الغرض ووجوبها بحكم العقل لتحصيل الغرض وجعلها ملاكاً لصحّة الأفعال العباديّة وعباديّتها.
ثالثتها: أنَّ المأمور به الّذي تكون له أجزاء متعدّدة وشرائط متكثّرة تارة يكون تمام أجزائه وشرائطه غير حاصلة، واُخرى يكون بعضها حاصلاً وبعضها غير حاصل، ولا ريب أنّ الأمر يدعو ويبعث المكلّف إلى إتيان الجميع في الصورة الاُولى وإلى الجزء أو الشرط الّذي لا يكون حاصلاً في الصورة الثانية، ولا يدعو إلى الحاصل لأنّه محال.
رابعتها: لا ريب أنّ الأمر ليس بنفسه علّة لإطاعة المكلّف وتحقّق المأمور به في الخارج بل الأمر لا يكون إلّا محقّقاً لموضوع الإطاعة الّذي ينتظره العبد بمقتضى واحدة من الحالات النفسانية الخمسة على سبيل مانعة الخلوّ وهي كما يلي:
الاُولى: اعتقاد المكلّف باستحقاق المولى للعبادة وأهليّته لها.
الثانية: وصول المكلّف إلى مرتبة فناء دواعيه النفسانية ومقهوريّته تحت نور جماله وجلاله وكبريائه، وتأثير عظمة المولى في نفسه، ونورانية سماء قلبه بسبب إشراقات أنوار كماله وقدرته وسائر صفاته وأسمائه، بحيث لو أمره المولى بفعلٍ تحرّكه هذه الملكة النفسانية بتمام شوقه وهمّه نحو العمل وإطاعة المولى.
الثالثة: يلاحظ المكلّف كثرة نعماء المولى وشدّة اهتمامه بتربية عبده وعظمة آلائه، فيراه مستوجباً لأنواع الشكر، فيقوم بأداء وظيفته وإطاعة أمر المولى حسب قدرته شكراً لبعض آلاء ربّه وتعظيماً له.
الرابعة: شدّة الخوف من عقاب ربّه بحيث يدعوه إلى إطاعة أوامره ونواهيه.
الخامسة: إشتياقه وطمعه بما عند ربّه من الفضل والإحسان وجزيل الثواب، بحيث يبعثه ذلك إلى تحصيل مرضاته وإطاعته دركاً لبعض فضله وجزيل ثوابه.
ص: 123
فهذه الحالات الخمسة كلّها أو بعضها تكون علّة لإطاعة المكلّف وامتثال أوامر مولاه.
وبمجرّد حصول واحدة منها تتحقّق علّة الإطاعة، بحيث لا يكون فصل بين هذه الحالة وإتيان العبد بما يتحقّق به إطاعة المولى إلّا أمر المولى. فالأمر إنّما يحقّق موضوع الإطاعة، وأمّا نفس الإطاعة فهي معلولة لإحدى الحالات الخمسة.
فتلخّص ممّا ذكر: أنّ إرادة الإطاعة وقصد العبادة من العبد تحصل قبل أمر المولى، وبعد صدور أمره يصير العبد في مقام الإتيان ويأتي بالمأمور به بقصد الطاعة بمقتضى هذه الحالة من غير أن يكون قصد الإطاعة مستنداً إلى الأمر.
إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم: أنّه يمكن التفصّي عن الإشكال بوجهين.
الأوّل: أنّ الأمر وإن كان متعلّقاً بالفعل مشروطاً بقصد القربة والامتثال إلّا أنّه لا يتعلّق الأمر بقصد القربة بنفسه ولا يدعو الأمر إليه أصلاً، ولا يكون هذا القصد متوقّفاً على الأمر حتى يستلزم المحال.
أمّا عدم تعلّق الأمر بقصد القربة بنفسه فلما ذكرناه آنفاً في المقدّمة الثانية من عدم تعلّق أمر حقيقيّ بالأجزاء والشرائط.
وأمّا أنّه لا يدعو الأمر إلى قصد القربة فلما ذكرناه كذلك في المقدّمة الثالثة من عدم دعوة الأمر إلى الشرط والجزء الحاصل. وقد تبيّن في المقدّمة الرابعة حصول ذلك الشرط، أي قصد القربة، بسبب إحدى الحالات المذكورة.
وأمّا عدم توقّف قصد الأمر على تحقّق الأمر بمعنى عدم استناده إليه فبمقتضى المقدّمة الرابعة أيضاً، فإنّ قصد القربة مستند إلى الحالات النفسانية المذكورة، فإذا أمره المولى بالصلاة والصيام مثلاً يوجد في نفسه بمجرّد هذا الأمر قصد إتيان الصلاة والصوم طاعة له من دون أن يكون هذا القصد مستنداً إلى الأمر.
الثاني: أنّ الأمر متعلّق بعنوان الصلاة إلّا أنّ انطباق هذا العنوان على هذه الأفعال
ص: 124
الخارجية موقوف على قصد القربة عقلاً، وقد كشف الشارع عن دخل قصد القربة في هذا الانطباق بسبب أخذه في متعلّق الأمر، لکنّه - أي القصد - ليس متوقّفا على انطباق ذلك العنوان على هذه الأفعال حتى يلزم الدور، بل هو متوقّف على إحدى الحالات الخمسة المذكورة.
هذا تمام الكلام فيما هو مناسب للمقام.
تستنتج ممّا مرّ نتيجتان:
الاُولى: إمكان التمسّك بالإطلاق إن قلنا بإمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر، وعدم إمكانه لو قلنا بعدم إمكان أخذه في المأمور به. فالذاهب إلى الأوّل يتمسّك بالإطلاق، والقائل بالثاني لا يتمسّك به.
الثانية: أنّه بعد فرض عدم إمكان التمسّك بالإطلاق ففي مقام العمل هل يكون الأصل العملي البراءة أو الاشتغال؟ فيه وجهان، يطلب تفصيله من مبحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّين لأنّه المناسب لهذا البحث، كما لا يخفى أنّ المناسب لمباحث الأوامر ليس إلّا البحث في ماهيتي التعبّدي والتوصّلي، والبحث عن إمكان أخذ قصد التقرّب في الأمر وعدمه، فلذلك نكتفي بهذا المقدار من مقتضى الأصل اللفظي والعملي، ونختم الكلام في المقام. والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على خير خلقه أجمعين محمّد وآله الطاهرين.
ص: 125
ص: 126
وفيه مبحثان:
المبحث الأوّل: في المرّة والتكرار
المبحث الثاني: في الفور والتراخي
الحقّ أنّه لا دلالة للصيغة على المرّة ولا على التكرار،((1)) بل لا تدلّ إلّا على طلب إيجاد الطبيعة، سواء كان المراد من المرّة الفرد الواحد من الطبيعة أو الدفعة((2)) بمعنى إيجاد الطبيعة دفعة واحدة ولو كان في ضمن أزيد من الفرد الواحد. وسواء كان مراد القائل بالمرّة عدم وجوب إتيان الزائد عليها بمعنى أنّ المأمور به المرّة لا بشرط حتى لا يكون الإتيان بالزائد موجباً للبطلان أو كان مراده بالمرّة بشرط لائية المأمور به حتى يكون الإتيان بالزائد موجباً لفساد المأتيّ به. ففي جميع هذه الصور نقول بعدم
ص: 127
دلالة الصيغة إلّا على طلب إيجاد الطبيعة، فليست للصيغة دلالة على المرّة أصلاً. وهكذا الكلام في جانب التكرار سواء كان مرادهم من التكرار تكرار المرّة بالمعنيين الأوّلين أو بالمعنيين الثانيين.
بناءً على المختار إذا أتى بفرد من المأمور به يسقط الأمر ويكتفى به في مقام الامتثال. فلو أتى بفرد آخر ثانياً يكون لغواً، لأنّه قد سقط الأمر بإتيان الفرد الأوّل. والقول بعدم سقوطه يستلزم طلب الحاصل المحال.
ولا ريب في تحقّق الامتثال أيضاً لو أتى بأفراد متعدّدة دفعة واحدة، كما إذا أمره المولى بعتق رقبة فأعتق جميع عبيده، فلا شكّ في حصول الامتثال وسقوط الأمر.
ولكنّ الإشكال في أنّ هذا هل يُعدّ امتثالاً واحداً أو أنّه امتثالات متعدّدة؟ ففي المسألة أقوال، ثالثها: التفصيل((1)) والإحالة إلى قصد الممتثل، فلو قصد الامتثال بجميع الأفراد أي بکلّ فرد منها يكون ذلك امتثالات متعدّدة. وأمّا لو قصد الامتثال بالمجموع أو بواحد منها يكون امتثالاً واحداً .
وأمّا وجه القول الأوّل: أنّ المطلوب ليس إلّا إيجاد أصل الطبيعة، وأمّا التعيّنات والتشخّصات فهي خارجة عن متعلّق الطلب وتأتي من ناحية وجود الطبيعة في الخارج: فالدخل لها في المطلوب، ففي فرض الإتيان بأفراد متعدّدة لا يتحقّق الامتثال إلّا بأصل الطبيعة وهي أمر واحد.
وفيه: وإن كان المطلوب إيجاد أصل الطبيعة وعدم دخالة خصوصيّاتها المفردة فيه، إلّا أنّ المكلّف قد أوجد الطبيعة بإيجاد کلّ فرد وتُحمل الطبيعة على کلّ فرد بالحمل
ص: 128
الشائع الصناعي، والأفراد المتعدّدة الحاصلة دفعة من الطبيعة وجودات متعدّدة لها لا وجودٌ واحدٌ،((1)) وقد ذكرنا أنّ المطلوب بالصيغة ليس إلّا نفس الطبيعة فلا محالة يصدق على إيجاد کلّ فردٍ منها إيجاد تلك الطبيعة، فيصدق على إيجاد کلّ من الأفراد امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة، فلا يكون الامتثال امتثالاً واحداً بل يُعدّ امتثالات متعدّدة. وهذا، أي القول الثاني، أقوى القول في المسألة.
وأمّا القول بالتفصيل ودخالة القصد في تعدّد الامتثال وعدمه، فلا وجه له. نعم، لو كان الأمر تعبّدياً فبالنسبة إلى کلّ فرد قصد الامتثال يحصل الامتثال. وبالنسبة إلى فردٍ لم يقصد ذلك فلا، ولكن هذا لا يكون لدخالة القصد في الامتثال، بل لأجل عدم إتيانه بتمام المأمور به بالنسبة إلى فردٍ لم يقصد بإتيانه الامتثال.
بعدما ظهر لك عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار يظهر لك أيضاً عدم دلالته على الفور والتراخي، بل لم أجد قائلاً بدلالتها على التراخي. نعم، ذهب بعضهم كالشيخ الطوسي(قدس سره)((2)) إلى دلالته على الفور، فعلى هذا لا تكون المسألة إلّا ذات قولين لا أزيد.
الأمر عقيب الحظر ثم إنّه لا يخفى عليك: أنّه وإن اختلفوا في دلالة الأمر الصادر عقيب الحظر أو توهّمه في دلالته على نفي الحظر السابق ورفع توهّمه - أي الإباحة - أو الوجوب، ولكنّ الحقّ عدم وجود ضابطة في ذلك، فعلى المجتهد التامّل التامّ في الموارد، لأنّه قد يكون ظا
ص: 129
ص: 130
إعلم: أنّ كلمات الاُصوليّين اختلفت في تحرير عنوان المسألة، فبعضهم قال: إنّ الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا؟((1)) وبعضهم قال: إنّ الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أم لا؟((2)) وبعضهم زاد عليه قَيد «على وجهه»((3)) ردّاً على ما ذهب إليه القاضي عبد الجبّار العامّي،((4)) الّذي أدخل هذه المسألة في الاُصول وقال فيها بعدم الإجزاء. وسبب ذلك أنّه رأى في الفقه أنّ المكلّف لو صلّى مع الطهارة المستصحبة ثم بان الخلاف لا تجزيه
ص: 131
تلك الصلاة، فذهب إلى القول بأنّ الإتيان بالمأمور به لا يقتضي الإجزاء، فأجابوا عنه بأنّ العلّة للإجزاء إتيان المأمور به على وجهه، أي بتمام ما هو معتبر فيه وموجب لتحصيل الغرض، وتلك الصلاة ليست كذلك فيحكم بعدم الإجزاء.((1))
فهذا هو السبب لإضافة القيد المذكور إلى العنوان لا ما ذكره صاحب الكفاية من أنّه اُضيف في العنوان ليكون شاملاً ما يعتبر في المأمور به شرعا وعقلاً كقصد القربة الّذي لا يمكن أخذه - على مبناه - في المأمور به، فهذا القيد جاء في العنوان حتى يشمل قصد القربة المعتبر عقلاً، فلا نظر فيه إلى خصوص ما يعتبر شرعاً، لأنّه عليه يكون توضيحيّاً لا احترازيّاً.((2))
وفساد هذا التفسير يظهر لمن يتأمل في تاريخ حدوث القيد المذكور، فإنّه قيد نشأ بين القدماء، فكيف يمكن أن يكون ناظراً إلى خلاف المتأخّرين من إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به؟ وقد نشأ هذا الخلاف في زمن الشيخ الأنصاري(قدس سره)((3)) وهو أوّل من تفطّن بالموضوع، فلا وجه لما ذكره في الكفاية.
كما أنّه لا وجه لكون هذا القيد إشارة إلى قصد الوجه، لأنّه مضافاً إلى ما أنكره الأكثر((4)) لا خصوصية له بالذكر.
لا يخفى عليك: أنّ المراد من «الاقتضاء» في قولهم: «إنّ الأمر يقتضي الإجزاء» هو
ص: 132
«دلالة» الأمر على إجزاء الإتيان بالمأمور به.
وأمّا المراد منه (الاقتضاء) إذا نسب إلى الإتيان بالمأمور به هو العلّية التامّة((1)) من حيث إنّ الآمر الحكيم إذا أمر بشيء لأجل حصول غرض فلا محالة يأخذ تحت أمره کلّ ما له دخل في تحصيل غرضه ولا يجوز عليه أن يأمر بما هو أعمّ من محصّل غرضه أو أخصّ منه، وإلّا يكون ناقضاً لغرضه، وحينئذٍ إذا أتى المكلّف بالمأمور به على وجهه فلابدّ من حصول الغرض وتحقّق الامتثال وسقوط الأمر. أمّا حصول الغرض، فلأنّ المولى أخذ کلّ ما له دخل في حصول غرضه في المأمور به وقد أتى المكلّف به. وأمّا تحقّق الامتثال، فلأنّه يتحقّق بإتيان المأمور به على وجهه، والمفروض أنّ المكلّف أتى به كذلك. وأمّا سقوط الأمر، فلأنّه لا مجال بعد ذلك لبقائه وإلّا يلزم طلب الحاصل، وهو محال، كما لو أمر به ثانياً.
ومن هنا يظهر معنى الإجزاء بأنّ معناه والمراد منه كفاية المأتيّ به عن الغرض الموجب للأمر.((2)) وهذا موافق لما ذهب إليه القائل بالإجزاء، وأمّا القائل بعدم الإجزاء فينكر ما ذكرناه من الدلالة والعلّية وكفاية الإتيان بالمأمور به عن الغرض.
لا يخفى عليك: الفرق بين مسألتنا هذه((3)) ومسألة المرّة والتكرار، فإنّ النزاع في مبحث المرّة والتكرار إنّما يجري في أنّ المأمور به بحسب دلالة الأمر هل هو المرّة أو التكرار؟ وهذا بخلاف ما نحن فيه، إذ النزاع هنا واقع في أنّ الإتيان بالمأمور به مرّة
ص: 133
كان أو مكرّراً هل يجزي أم لا؟ فالنزاع الواقع في مسألة الإجزاء يكون كبروياً وفي مسألة المرّة والتكرار صغروياً.
وأمّا الفرق بين هذه المسألة و مسألة تبعية القضاء للأداء فممّا لا يحتاج إلى بيان، لأنّ البحث في مسألة التبعية في أنّ وجوب القضاء هل هو بالأمر الأوّل أو يحتاج إلى أمر جديد؟ مضافا إلى أنّ موردها عدم الإتيان بالمأمور به، وهذا بخلاف مسألة الإجزاء، فإنّ موردها الإتيان بالمأمور به والبحث في إجزائه وعدمه.
هذا تمام الكلام في مقدّمات البحث. وأمّا الكلام في أصله، فيقع في ثلاث مواضع. ونبدأ سائلين من الله تعالى الإعانة والتوفيق فإنّهما خير رفيق.
يقع البحث هنا في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي، والمأمور به بالأمر الظاهري، والمأمور به بالأمر الاضطراري عن التعبّد ثانياً بکلّ واحد من هذه الأوامر في نفس مرتبتها، فنقول:
لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي - وهو الأمر الّذي يتعلّق بالموضوع بما هو و بعنوانه الأوّلي - عن الأمر به ثانياً.
كما لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري - وهو الّذي يتعلّق بالموضوع بملاحظة العجز عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الأوّلي - عن الأمر به ثانياً بنفس الأمر الاضطراري، وهكذا الكلام في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري - وهو الأمر المتوجّه إلى المكلّف في ظرف الاشتباه وجهله بالحكم الواقعي وموضوعه - فإنّه أيضاً موجب للإجزاء وسقوط أمره، فلا يجب الإتيان به في ثاني الحال مع بقاء جهله.
ص: 134
ولو فرض في هذه الثلاثة بقاء الأمر لكان لغواً، بل يكون محالاً لأنّه طلب الحاصل. ولا يمكن أيضاً الأمر بها بملاك الغرض الحاصل من الموارد الثلاثة، لعدم فوت شيء من الغرض، وهذا واضح.
أمّا ما ذكره في الكفاية((1)) من تبديل الامتثال، كما لو أمره المولى بإتيان الماء فأتى به ولكن لم يشربه المولى بعدُ فله أن يبدِّل ذلك الماء بماءٍ آخر.
ففيه: أنّ المكلّف وإن أتى بالفعل المتعلّق للأمر إلّا أنّه ما کان مطلوبا نفسيا، فما دام لم يحصل غرض المولى من ترويته وإسقائه لم يسقط أمره ومطلوبه النفسي، فعلى المكلّف إتيان الماء الموصل إلى الغرض والمطلوب النفسي، فليس ما ذكره من المثال من باب تبديل الامتثال.
هل يجزي الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري الواقعي بعد رفع الاضطرار أم لا؟ فهل تجب الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه أم لا؟ في المسألة فروض ممكنة، قال في الكفاية في تصويرها:
إنّ التكليف الاضطراري إمّا أن يكون وافياً بتمام الغرض والمصلحة، أو لم يكن كذلك، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه، أو لا يمكن، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه، أو بمقدار يستحبّ.
ص: 135
ثم ذكر أحكام الأقسام من الإجزاء وعدمه وجواز البدار في بعض الصور، وذكر أنّ المرجع في مقام الإثبات هو الإطلاق لو كان، كظاهر قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ...﴾((1)) الآية؛ وقوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «التیمّم أحد الطهورين»((2)) فإنّ ظاهرهما الإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء. وإلّا فالأصل يقتضي البراءة لكونه شكّاً في أصل التكليف.((3))
هذا، ولكنّه مبنيّ على تغاير الأمرين (الاختياري والاضطراري) وكونهما في عرض واحد، فعليه يبحث عن كفاية أحدهما عن الآخر. وأمّا بناءً على التحقيق في المسألة من طولية الأفراد وتعلّق الأمر بالطبيعة الّتي لها أفراد ومصاديق بعضها لصورة الاختيار وبعضها الآخر لصورة الاضطرار، فلا يأتي البحث عن كفاية أحدهما عن الآخر، فإنّ الصلاة - مثلاً - طبيعة لها أفراد ومصاديق بحسب أحوال المكلّفين، ففي حال فقدان الماء يكون فردها ومنطبقها الصلاة مع الطهارة الترابية، وفي حال وجدان الماء يكون ما تصدق عليه الطبيعة المأمور بها الصلاة مع الطهارة المائية. وأيضاً في حال تمكّن المكلّف من القيام يكون ما ينطبق عليه عنوان المأمور به والطبيعة الواقعة تحت الأمر الصلاة قائماً، وفي حال عدم تمكّنه من القيام يكون مصداق الطبيعة المذكورة الصلاة قاعداً، وفي حال عدم تمكّنه منه الصلاة مضطجعاً، فجميع هذه الصلوات أفراد لطبيعة الصلاة، وهي تصدق على کلّ واحدة منها، فلا يبقى مجال لبحث الكفاية.
ومن الواضح: أنّ متعلّق الأمر في قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ طبيعة الصلاة، هذه
ص: 136
فرد لها وتلك فرد آخر وهكذا، وهذا ممّا لا إشكال فيه، فما حُكي عن الشيخ(قدس سره) من بدلية صلاة المتيمّم المضطرّ عن الصلاة الكامل المختار، بعيد عن الصواب ومخالف لظواهر الأخبار والكتاب كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طِيِّباً﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ...﴾((1)) الآية؛ وقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أوْ رُكْبَاناً...﴾((2)) الآية.
فإنّ الظاهر من الآيتين كون الصلاة مع الطهارة الترابية في حال عدم وجدان الماء، وراكباً في حالة الخوف فردان واقعيّان لطبيعة الصلاة المأمور بها، كما أنّ الصلاة مع الطهارة المائية في حال وجدان الماء، والصلاة في غير حال الخوف فردان لها من غير فرق بينها.
والحاصل: أنّه وإن كان يظهر من كلمات المتأخّرين أنّ محلّ النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن المأمور به الواقعي فيما يكون للشارع أمر متعلّق بالمكلّف في حال الاختيار، وأمر آخر متعلّق به في حال الاضطرار، إلّا أنّ هذا بعيد عن الصواب وغير قابل لأن يُعدّ محلّ البحث والنزاع؛ لأنّه لا ينبغي توهّم إجزاء الإتيان بما هو المأمور به لأمر عمّا هو المأمور به لأمر آخر وإلّا فيصحّ أن يكون النزاع في إجزاء الإتيان بالصلاة عن الصوم والزكاة وغيرهما. نعم، يمكن دلالة دليل بالخصوص على ذلك في مورد واقتصار المولى في صورة الإتيان بأحدهما عن الآخر، ولكن هذا غير إجزاء نفس الإتيان بأحدهما عن الآخر، فالصحيح أن يكون محلّ البحث: إجزاء الإتيان بالفرد الاضطراري عن الأمر بالطبيعة. ولعمري هذا واضح
ص: 137
غير محتاج إلى بيان، ولكن حيث كان ظاهر عباراتهم موهماً لذلك، أطلنا الكلام فيه. ولذا لو راجعنا كلمات المتقدّمين، نجد في بعض كلماتهم ما يوافق ما ذكرناه ويصدّقه، مثل ما يستفاد من المحقّق(قدس سره) في المعتبر في مسألة: إذا كان معه ماء فأراقه، ما هذا لفظه: «إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت، أو مرّ بماءٍ فلم يتطهّر ودخل الوقت ولا ماء، تيمّم وصلّى ولا إعادة، ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك. وللشافعي وأحمد هنا روايتان، أحدیهما: يعيد؛ لأنّه فرّط في الصلاة مع القدرة على طهارة كاملة. لنا أنّه صلّى مستكملة الشرائط، فتكون مجزية. والإراقة للماء سائغة، فلا يترتّب عليها لواحق التفريط».((1))
هذا ولا يخفى: أنّه ليس محلّ النزاع أيضاً صورة بقاء حالة فقدان الماء، أو عدم التمكّن من القيام أو القعود وغيرها إلى آخر الوقت، لأنّه ليس في هذه الصور تخيير للمكلّف في إتيان الفرد الاضطراري والاختياري مع انحصار ما هو منطبق لطبيعة الصلاة المأمور بها بفرد واحد، فلا يكون الفرد الاختياري فرداً بحسب حاله، فلا ينبغي في هذه الصورة توهّم عدم الإجزاء.
فروح البحث ومرجع النزاع راجع إلى ما إذا كان المكلّف فاقداً للماء في أوّل الوقت، وواجداً له في آخر الوقت، وأتى بالمأمور به في حال الاضطرار.
ولم نقل بأنّ المستفاد من الأدلّة كون الصلاة مع الطهارة الترابية فرداً لها في حال فقدان الماء في جميع الوقت، حتى لو لم يبق المكلّف على حاله من فقدان الماء في جميع الوقت يجب الالتزام بعدم كون ما أتى به فرداً للطبيعة المأمور بها؛ لأنّه لو قلنا ذلك لم يبق لهذا النزاع مجال أصلاً، ولم تترتّب عليه فائدة وثمرة.
ص: 138
فالنزاع يقع فيما إذا قلنا بأنّ المستفاد من الأدلّة أنّ للواجب بحسب حال المكلّف فردين، فرد مع الطهارة الترابية في أوّل الوقت، وفرد مع الطهارة المائية في آخره، فما هو المنطبق على للطبيعة المأمور بها في أوّل الوقت فرد، وفي آخره فرد آخر. بمعنى أنّ المكلّف مخيّر إمّا شرعاً((1)) وإمّا عقلاً فيما كلّفه الشارع - من إتيان الصلاة - أن ينتخب أحد فردي الطبيعة.
إذا عرفت محلّ النزاع ومركب البحث، فاعلم: أنّ مقتضى القاعدة، كما ظهر لك ممّا ذكر، فيما إذا أتى المكلّف بالصلاة في أوّل الوقت مع الطهارة الترابية، إجزاؤها عن صلاة اُخرى في آخر الوقت مع الطهارة المائية. إذ لا مجال لعدم الإجزاء وعدم سقوط الأمر بعد إتيان ما هو فرد للمأمور به. نعم، يمكن دلالة دليل خاصّ على عدم إجزاء الفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري، لكن هذا فيما إذا لم يكن إطلاق للأمر المتعلّق بالطبيعة فيدلّ على فردية ذلك الفرد بمجرّد عروض حالة فقدان الماء، أو عدم التمكّن من القيام.
ثم إنّ المحقّق الخراساني(قدس سره) بعدما ذكر في مقام الإثبات: أنّ المتَّبع هو الإطلاق لو كان، قال: «وإلّا فالأصل، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكّاً في أصل التكليف... إلخ».((2))
وفيه: أنّه لو لم يكن إطلاق للدليل، لا مجال لإجراء البراءة والقول بالإجزاء، بل المرجع هو الاشتغال؛ لأنّ الشكّ بعد العلم بأصل التكليف يرجع إلى الشكّ في
ص: 139
السقوط بأنّ التكليف الثابت يقيناً هل سقط بالإتيان الكذائي أم لا؟ ولا ريب في أنّ المرجع حينئذٍ هو الاشتغال، فلابدّ من القول بوجوب الإعادة أو القضاء.
لا يذهب عليك وجه ما ذهبنا إليه في الفقه في بعض حواشينا، وما كان في فتاوى المتقدّمين، من عدم إجزاء بعض الأفعال في ظرف الاضطرار عمّا هو المأمور به في حال الاختيار، كما إذا حكم قاضي العامّة بالعيد في يوم الثلاثين من شهر رمضان، فالواجب على المكلّف في موارد التقيّة، متابعة رأيه وإفطار الصوم، لحفظ نفسه ودفع ضررهم،((1)) فإنّ الحكم في المقام عدم الإجزاء؛ لعدم ما یدلّ على انطباق عنوان الصوم المأمور به على هذا العمل، وكونه فرداً لطبيعة الصوم. غاية الأمر یدلّ على عدم حرمة الإفطار وعدم وجوب الإمساك تكليفاً لا وضعاً، فلا يدلّ على عدم كون الأكل مفطراً. وليس هذا كالصلاة مع الطهارة الترابية في أوّل الوقت إذا كان فاقداً للماء، فإنّها مصداق لطبيعة الصلاة المأمور بها كما لا يخفى.
فإذا كان الإفطار بالاضطرار فرداً للطبيعة المأمور بها يسقط الأمر بالصوم أيضاً ولحكمنا بالإجزاء. وقس على ذلك نظائر هذا المثال في كلّ مورد يرفع دليل الاضطرار الأمر بالطبيعة فقط من دون أن يجعل المضطرّ إليه فرداً للطبيعة، والله الهادي إلى الصواب.
ص: 140
قال في الكفاية بما ملخّصه: لو كان الدليل الدالّ على الحكم الظاهري أصلاً من الاُصول العملية كأصالة الطهارة والحلّية فالإتيان بالمأمور به يكون مجزياً عن الواقع حتى في صورة انكشاف الخلاف.
وأمّا لو كان دليله الأمارة، فإن قلنا بطريقية الأمارات فلازمه عدم الإجزاء بعد انكشاف الخلاف. وأمّا إن قلنا بالسببية وأنّه بواسطة قيام الأمارة على شيء توجد في المؤدّى مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع ومفسدة تركه، فلابدّ من القول بالإجزاء لو كانت المصلحة المتدارك بها مطابقة لمصلحة الواقع، وإن لم تكن مطابقة لها فالكلام الكلام المذكور في الأمر الاضطراري.
وأمّا في صورة الشكّ في كون الأمارة حجّة من باب الطريقية أو السببية فمقتضى أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف الإعادة في الوقت... إلخ.
وأفاد في وجه إجزاء الحكم الظاهري فيما يكون دليله الأصل: بأنّ ذلك مقتضى ملاحظة دليل الأصل ودليل الحكم الواقعي، وبيان ذلك: أنّا نلاحظ قوله(قدس سره): «كلّ شيء طاهر»؛((1)) ونستفيد منه تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطهارة الواقعية؛ لأنّه لو اُريد منه ظاهره يلزم الكذب، فيستفاد منه أنّ کلّ شيء بمنزلة الطاهر الواقعي حتى انكشاف الخلاف ثمّ ينضمّ هذا الدليل إلى دليل الحكم الواقعي - وهو اشتراط الصلاة
ص: 141
بطهارة البدن واللباس، مثل قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا صلاة إلّا بطهور»؛((1)) و «لا يقبل الله تلك الصلاة إلّا فيما أحلّ الله أكله»، فنستنتج من الجمع بينهما: أنّ شرط الصلاة هي الطهارة الّتي تكون أعمّ من الظاهرية والواقعية، وكذلك حلّية اللباس؛ لأنّ دليل الأصل حاكم عليه وناظر إليه ومبيّن لدائرة الشرط، هذا.((2))
ولا يخفى عليك: أنّ تقسيمه - على الظاهر - ليس بحاصر؛ لأنّ تقسيمه إنّما يكون متكفّلاً لبيان الحكم في الموضوعات والشبهات الموضوعية بأنّه إذا كان الحكم الظاهري ممّا يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه وكان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلّية، فانكشاف الخلاف لا یدلّ على عدم إجزائه عن الحكم الواقعي. وإذا كان الحكم الظاهري بلسان تحقّق ما هو الشرط واقعاً، كالأمارة، فبناءً على الطريقية لا يجزي، وبناء على السببیّة يجزي لو كان وافياً بتمام المصلحة، أو لم يكن وافياً بتمام المصلحة ولكن كان الباقي غير ممكن التدارك، أو غير واجب التدارك.
فكما ترى ليس في كلامه حكم الشبهات الحكمية مثل ما إذا شكّ في جزئية السورة ودلّت الأمارة أو دليل شرعي آخر كأصالة البراءة على عدمها، ثم انكشف الخلاف. فكلامه ساكت عن حكم هذه الصلاة الفاقدة للسورة الّتي تكون فرداً لطبيعة الصلاة وأنّها مجزئة عن الصلاة الواجدة لها أم لا؟
لا يقال: إنّه قد ذكر في آخر كلامه حكم الفرض المذكور بقوله: «وأمّا ما يجري في إثبات أصل التكليف... إلخ».
ص: 142
لأنّه يقال: المذكور في آخر كلامه ليس إلّا حكم صورة الشكّ في الموضوعين، أي صلاة الظهر والجمعة. وأمّا الحكم بالنسبة إلى الشبهات الحكمية الراجعة إلى موضوع واحد كالشكّ في أصل جزئية السورة ليس مذكوراً في كلامه.
إنّ النزاع في إجزاء الأوامر الظاهرية - سواء كان دليلها الأصل أو الأمارة - عن الأوامر الواقعية، لا يقع فيما إذا قامت أمارة أو أصل على نفي وجوب شيء ثم انكشف أنّ الواقع وجوبه، أو على وجوب فعل مع كون الواجب غيره، كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف أنّ الواجب صلاة الظهر، فهذه الموارد خارجة عن محطّ النزاع لأنّه لا إشكال في عدم إجزاء الإتيان بمتعلّق أمر عن متعلّق أمر آخر.
فمحلّ الكلام ومورد النقض والإبرام في مركّب ذي أجزاء وشرائط وموانع، بأن يكون الحكم - أصلاً كان دليله أو أمارة - دالّا على عدم اعتبار شيء في المأمور به أو عدم قاطعية شيء فيه، أو دلّ على حصول جزء أو تحقّق شرط من شروط المأمور به ثم انكشف بعد الإتيان خلاف ذلك.
وبعبارة اُخرى: النزاع واقع فيما إذا كان الحكم راجعاً إلى كيفيّات المأمور به.
وبعبارة ثالثة: محلّ النزاع ومورد الكلام فيما إذا كان الحكم متعلّقاً بعنوان كالصلاة ودلّ الحكم الظاهري على حصول هذا العنوان في ظرف الشكّ. فلا مجال لتوهّم وجود أمرين في هذه الموارد يكون أحدهما متعلقاً بالواجد للسورة مثلاً وهو الحكم الواقعي، والآخر متعلّقاً بالفاقد لها في صورة الجهل وهو الحكم الظاهري. بل ليس في البين إلّا أمر واحد متعلّق بطبيعة الصلاة - مثلاً - يكون لها مصداق واقعي ومصداق آخر ظاهري، فيبحث عن إجزاء الإتيان بالمصداق الظاهري عن الأمر بالطبيعة.
ص: 143
وعلى کلّ حال، فمقتضى التحقيق حسبما يؤدي إليه النظر الدقيق أن يقال: إنّ الكلام تارة يقع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري فيما يكون دليل الحكم أصلاً من الاُصول. واُخرى في إجزائه فيما يكون الدليل الدالّ عليه أمارة من الأمارات. ولنقدّم الكلام فيما يستفاد من الجمع بين دليل الحكم الظاهري - أصلاً كان أو أمارة - ودليل الحكم الواقعي بحسب مقام الإثبات، وذلك ينعقد في مقامين:
إذا كان دليل الحكم أصلاً من الاُصول، كأصالة الطهارة وأصالة الحلّية وقاعدة البناء على إتيان ما شكّ في إتيانه بعد الدخول في الجزء المترتّب عليه، أي قاعدة التجاوز أو الفراغ،((1)) نلاحظ مفاد کلّ واحد من أدلّة هذه الاُصول مثل «كلّ شيء طاهر...»؛((2)) أو «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال...»؛((3)) ونرى دلالة الأوّل على الحكم بطهارة مشكوك الطهارة والثاني على حلّية مشكوك الحلّية، ثم نلاحظ الأدلّة الأوّلية الدالّة على اشتراط الصلوات الخمس اليومية بطهارة البدن واللباس،
ص: 144
فنحكم في ظرف الشكّ بمقتضى الجمع بين الدليلين باشتراط الصلاة بالطهارة والحلّية أعمّ من الظاهرية والواقعية. فدليل الأصل يوسّع دائرة التكليف ويبيّن وظيفة المكلّف في حال الشكّ بأنّ تكليفه في حال الشكّ يكون هكذا استمرّ شكّه بعد ذلك أم لا؟ فلا يتصوّر في مثله انكشاف الخلاف وعدم الإجزاء، لأنّه عمل بوظيفته وأتى بما هو مأمور به ومصداق للطبيعة.
وهكذا الحال بالنسبة إلى قاعدة التجاوز أو الفراغ، وهي قوله: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»؛((1)) فإنّ مفادها جواز البناء على إتيان المشكوك بعد الدخول في الجزء المتأخّر عنه. وهذا حكم تعبّدي مورده الشكّ الفعلي، توسّع به دائرة موضوع الصلاة. وليس مشروطاً باستمرار الشكّ، بل بمجرد حدّوث الشكّ يبنى على الإتيان، سواء استمرّ شكّه أم لا، فنستفيد من ملاحظة دليل هذه القاعدة مع دليل وجوب الصلوات اليومية فردية المأتيّ به للطبيعة المأمور بها ولو كان في الواقع فاقداً للجزء المشكوك، فهذا المأتيّ به فرد للصلاة منطبق لعنوانها، كما أنّ الفرد الواجد للجزء أو الواقع مع الطهارة الواقعيّة فرد لها. وهذا معنى إجزاء الفرد المأتيّ به في حال الشكّ عن الأمر بالطبيعة.
وكذلك الحال إذا دلّ الأصل كالبراءة الشرعية، على نفي جزئية شيء أو شرطيته أو عدم قاطعيته، فإنّ مقتضى ما يستفاد من حديث الرفع((2)) في جنب الأحكام الواقعية: كون الأصل المصطاد من مثل هذا الحديث حاكماً على تلك الأحكام وموسّعاً لدائرة الموضوع في ظرف الجهل أو النسيان، وأنّ هذا الفرد الفاقد للجزء (المنفيّ جزئيّته
ص: 145
بالأصل) فرد للمأمور به، فلا إشكال في کلّ ما كان من هذا القبيل من القول بالإجزاء واتّساع نطاق المأمور به. هذا كلّه فيما كان دليل الحكم الظاهري أصلاً.
وأمّا إذا كان دليل الحكم الظاهري أمارة من الأمارات كما إذا قامت البيّنة على إتيان الركوع، أو أخبر عدل بقراءة السورة، أو عدم جزئيّتها للصلاة، أو عدم مانعية القهقهة لها، وغير ذلك. فإن قلنا بلزوم ملاحظة لسان نفس الأمارة مع دليل الحكم الواقعي، فدلالته على عدم الإجزاء ممّا لا ينكر، لأنّ لسان الأمارة كما ينادي بحصول ما هو الشرط واقعاً، ينادي أيضاً بعدم الإجزاء بعد كشف الخلاف.
ولكنّنا لا نلاحظ لسان الأمارة بل نلاحظ دليل حجّية الأمارة مثل قول الشارع: إبن على قول العادل مثلاً، أو صدّق العادل، وما في معناهما، ونلاحظ معه دليل الحكم الواقعي، فلا نجد حينئذٍ فرقاً بين الاُصول والأمارات، فكما أنّ مقتضى ظهور دليل الأصل ودليل الحكم الواقعي كفاية الإتيان بالمصداق الظاهري للطبيعة، كذلك مقتضى ظهور دليل الأمارة عند ملاحظته مع الحكم الواقعي طابق النعل بالنعل، فيستفاد منهما أيضاً كفاية الإتيان بالمصداق الظاهري.
ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا بأنّ دليل التعبّد بالأمارة لا يفيد الإجزاء، فلا وجه مع ذلك لما أفاده المحقّق الخراساني في الكفاية بقوله: «وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً كما هو لسان الأمارات فلا يجزي، فإنّ دليل حجّیته حيث كان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه لم يكن كذلك».((1))
وذلك لأنّ دليل حجّية الأمارة ليس نفس الأمارة حتى يقال بأنّ لسانه لسان أنّه
ص: 146
واجد لما هو الشرط واقعاً، بل الدليل على حجّیتها هي الأدلة الّتي أقاموها على حجّية الخبر وغيره وليس في لسان هذه الأدلّة تحقّق ما هو الشرط أو رفع المانع واقعاً، بل مفادها التعبّد بقول العادل مثلاً في جعل الناقص فرداً للمأمور به تعبّداً.
والحاصل: أنّه لا فرق بين دليل الأصل والأمارة، فكما أنّ قوله: «كلّ شيء طاهر» يعيّن وظيفة المكلّف في ظرف الشكّ، كذلك حديث الرفع وغيرهما، فإنّ مقتضى هذه الاُصول في ظرف الشكّ إجزاء الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط مثلاً عن الواقع وكونها فرداً لطبيعة الصلاة كما أنّ صلاته الواجدة لهما في حال العلم تكون فرداً لها، كذلك مقتضى قوله: صدّق العادل مثلاً، وابن على قوله، تعيين وظيفة المكلّف في حال الشكّ، وبيان أنّ ما أخبر به العادل من إتيان الركوع أو عدم جزئيّة السورة للصلاة مثلاً فرد للطبيعة المأمور بها؛ لأنّ الواجب هو البناء العملي على قول العادل وإلغاء احتمال الخلاف عنه وترتيب آثار الصدق عليه بأن يعدّ المخبر عنه في ظرف الشكّ فرداً للمأمور به. فلا فرق بين لسان الأمارة ولسان الأصل، فإنّ كلّا منهما يعيّن تكليف الشاكّ في مقام الامتثال ويكون مرآة للفرد الّذي به يحصل الامتثال في ظرف الشكّ، فكما أنّ الأوّل موجب للإجزاء فليكن الثاني أيضاً كذلك.
إنّ ما ذكرناه من عدم الفرق بين الأمارات والاُصول في اقتضائهما الإجزاء، لا ينافي حكومة الأمارات على الاُصول، وذلك لأنّ المماثلة والمساواة إنّما تكون في مجرّد كون کلّ منهما حكم الشاكّ في مقام الامتثال، لا أنّ الأصل يكون كالأمارة في جميع الجهات، فإنّ من الواضح تقديم الأمارة على الأصل، لأنّ موضوعه - وهو الشاكّ - يزول بمقتضى الأمارة الّتي يبدّل الموضوع من الشاكّ إلى العالم بالحكم، يعامل
ص: 147
بمفادها معاملة الواقع، وينزّل منزلته، فدليلها مفسّر لدليل الأصل وشارح له وحاكم عليه، فلا يبقى معها مجال لجريان الأصل.
فتلخّص من جميع ما أسلفناه: أنّ مقتضى ظهور دليل الأصل أو الأمارة بعد ضمّهما إلى دليل الحكم الواقعي كون الفعل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط فرداً للطبيعة الواقعة تحت الأمر. وهذا معنى الإجزاء المذكور في كلام القدماء من الفقهاء كالعلّامة والمحقّق وغيرهما5. فعلى هذا، يكون الفرد المأتيّ به في حال الشكّ فرداً للمأمور به واقعاً، ومجزياً عن الفرد الآخر. هذا تمام الكلام في مقام الإثبات والاستظهار من الاُصول والأمارات الشرعية.
وأمّا الكلام بحسب مقام الثبوت: فحاصله أنّه يرد على القول بالحكم الظاهري والواقعي وجوه من الإيراد: من لزوم اجتماع النقيضين، أو الضدّين، أو المثلين، أو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة.
ولا يمكن الذبّ عنها بتقييد الحكم الواقعي بالحكم الظاهريّ، وتخصيص الحكم الواقعي بصورة العلم به؛ لأنّ هذا إنّما يتمّ لو كان الحكم الظاهري والواقعي في عرض واحد، وواردين على موضوع واحد، وأمّا مع تأخّر الحكم الظاهريّ عن الواقعي برتبتين (إحداهما نفس الحكم الواقعي، والثانية الشكّ فيه) فلا يمكن التقييد أو التخصيص؛ لأنّ الموضوع في أحدهما هو الشكّ في موضوع الآخر، فهما داخلان في باب التعارض.
هذا مضافاً إلى أنّ التقييد أو التخصيص مستلزم للدور؛ لأنّ الحكم بوجوب الصلاة مثلاً لو كان مقيّداً بصورة العلم به يلزم توقّف الحكم على العلم به، ولا ريب في أنّ العلم بالحكم أيضاً متوقّف على الحكم.
فالحقّ في الجواب أن يقال: إنّ الحكم إنّما اُنشئ مطلقاً من غير تقييد بالعلم والجهل.
ص: 148
وليس معنى إطلاقه أنّ المشكوك والمعلوم قد تعلّقت بهما إرادة الآمر، بل معناه أنّ الآمر أنشأ الحكم عارياً عن هذه القيود . إلّا أنّه لا يريد انبعاث المكلّف منه إلّا في ظرف العلم به. وذلك - أي عدم إرادة انبعاثه في صورة الجهل - ليس لقصور في ناحية الحاكم، بل القصور يكون في ناحية الحكم وهو في سلسلة علل الانبعاث، فإنّ الحكم لا يمكن أن يكون علّة لانبعاث المكلّف وحصول إرادة الفعل في نفسه إلّا في صورة علمه بالحكم، فالقصور راجع إلى ضيق دائرة العلّة.
ولو أراد الآمر انبعاث المأمور في جميع الأحوال فلابدّ له من التمسّك بأمر آخر يتعلّق بموضوع يكون دائم الموافقة أو غالب الموافقة مع الواقع، كأن يقول: إذا احتملت وجوب شيء فأت به.
لا يقال: يمكن أن ينبعث العبد من الأمر الأوّل في حال الجهل أيضاً لاحتمال وجود الأمر، فلا يحتاج الآمر إلى أمر آخر غير الأمر الأوّل.
فإنّه يقال: إنّ انبعاثه على هذا لا يكون من الأمر، بل يكون من احتمال وجود الأمر، فحال وجود الأمر الأوّل وعدمه سواء في انبعاث العبد.
إذا عرفت ما قلناه من إنشاء الحكم غير مقيّد بالعلم والجهل، وعدم انبعاث العبد إلّا إذا كان عالماً بالحكم، يمكّنك حينئذٍ أن تجمع بين الحكمين الواقعي والظاهريّ، بأن يكون الحكم الواقعي بالنسبة إلى الجاهل أو المضطرّ متوقّفاً في مرتبة الإنشاء وعدم وصوله إلى مرتبة الفعلية، وإنّما الفعلي في حقّه هو الحكم الظاهري، وبذلك يرتفع التنافي بين الحكمين في حقّ شخص واحد.
إن قلت: إنّ التحقيق على ما أفاده المحقّق الخراساني(رحمه الله) بقاء فعليّة الحكم الواقعي في ظرف الشكّ، وعذرية الحكم الظاهري في صورة الخطأ، وكونه ترخيصاً للمكلّف في هذه الصورة.
ص: 149
قلت: فساد هذا التحقيق أوضح من أن يخفى على مثله؛ لأنّ التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي مع بقاء فعليته كالنار على المنار ولو فسّرنا الحكم الظاهري بالترخيص في ترك الجزء أو الشرط في صورة الشكّ، لأنّ الترخيص منافٍ للبعث الفعلي نحو الفعل، كما أنّ الزجر عنه ينافي البعث نحوه. فلا مناص ممّا ذكرناه لحلّ التنافي من اختصاص فعلية الحكم الواقعي بالعالم، هذا.
وأمّا الإشكال بأنّ الذهاب إلى الإجزاء في مسألتنا هذه موجب للتصويب المجمع على بطلانه.
فيظهر جوابه بعد ذكر مقدّمة وهي: أنّ مسألة التخطئة والتصويب من المسائل المذكورة في الكتب الكلامية من أوائل ظهور علم الكلام، وكذلك الكتب الاُصولية من زمن الشيخ الطوسي(قدس سره) الّذي هو أوّل من صنّف في الاُصول كتاباً مفصّلاً وهو «العدّة»((1)) بعدما صنّف فيه اُستاذه الشريف المرتضى(قدس سره) كتابه المختصر الموسوم ب- «الذريعة».
وبيانها: أنّه هل يكون لله تعالى بعدد آراء المجتهدين أحكام مختلفة حتى يكون كلّهم مصيبين أم لا؟ بل يكون حكم الله في حقّ الجميع واحداً ولا يكون المصيب من الآراء غير رأي واحد، فكلّ من كان رأيه مخالفاً لذلك الرأي يكون مخطئاً لا محالة.
واختلف القائلون بالتخطئة بأنّ المخطئ معذور أم لا؟ ونقل عن بعض معتزلة بغداد الذهاب إلى فسق المخطئ. وذهب الأكثر إلى معذوريّته.
إذا عرفت ذلك، يظهر لك عدم وجود الإجماع من جميع الاُمّة على بطلان التصويب. وأمّا إجماع الإمامية، فمن الواضح أنّ حجّية إجماعهم إنّما تكون من جهة
ص: 150
أنّهم أصحاب النصّ، بمعنى أنّهم لا يقولون ولا يفتون بمقتضى عقولهم والاستحسانات، كما يعملون أصحاب القياس في الأحكام الشرعية، فهم معتقدون أنّ النصّ الصادر من الأئمّة(علیهم السلام) حجّة كالنصّ الصادر من النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، وذلك بمقتضى النصوص المعتبرة، منها حدّيث الثقلين عنه(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ).
وهذه، أي حجّية أقوالهم وآرائهم، غير الخلافة والرئاسة العامّة التي تدّعي الشيعة أنّها لهم(علیهم السلام)، بل ولو لم نقل بذلك فلابدّ من القول بحجّية آرائهم(علیهم السلام) بمقتضى الحديث الشريف المذكور وأمثاله.((1))
فإذا ثبت إجماع الإماميّة على مسألة وتوافقهم عليها خلفاً عن سلف مع علمنا بأنّهم لا يقولون من عند أنفسهم ولا يتّبعون مقتضى رأيهم ولا يفتون إلّا بما عن النبيّ والأئمّة - صلوات الله عليهم أجمعين - فنكشف من ذلك قول أئمّتهم(علیهم السلام) ومطابقته لما أجمعوا عليه.
ولكن هذا الإجماع لم يقم في ما نحن فيه. وإنّما الشيخ(قدس سره) قال في «العدّة» بإجماع المتکلّمين من المتقدّمين والمتأخّرين من الإمامية على بطلان التصويب.((2)) وهذا كما ترى غير الإجماع المصطلح المعلوم حجّیته عندنا وإن كان للمتكلمين على بطلان التصويب دلائل قطعية بأنّ حكم الله في حقّ الجاهل والعالم على حدّ سواء، ولكن أنّى هذا من الإجماع المصطلح، فلا يمكن للخصم أن يتمسّك به لردّ ما اخترناه من أنّه يوجب التصويب المجمع على بطلانه.
هذا، مضافاً إلى أنّ مختارنا ليس من التصويب الّذي قد اُدّعي الإجماع على بطلانه؛ لأنّا نقول بأنّ الحكم الواقعي مطلق وغير مقيّد بصورة العلم والجهل، بل تقيّده بذلك ممتنع، لأنهّ مستلزم للدور، ولكن الشارع الحاكم حيث يرى عدم إمكان تحريك
ص: 151
الجاهل بسبب الأمر وعدم انبعاثه من ذلك الحكم المطلق، فلا يريد انبعاثه من الحكم إلّا في صورة علمه به.
فإنشاء الحكم غير مقيّد بصورة العلم والجهل، ولكنّ الحكم حيث ينشأ لأن يكون محرّكاً للمكلّف وباعثاً له نحو الفعل؛ فلا يمكن أن يكون علّة لانبعاث الجاهل، فلابدّ للآمر أن يريد بذلك الحكم انبعاث العالم.
ولو أراد صدور الفعل من الجميع فعليه أن يتوصّل إلى مراده بإلقاء خطاب آخر يكون متوجّهاً إلى المكلّف في ظرف الشكّ والجهل بإيجاب الاحتياط والإتيان بجميع المحتملات، وحيث إنّ ذلك موجب لاختلال النظام من جهة العسر الشديد، فله أن يوسّع دائرة المأمور به بتوسّط خطاب آخر في ظرف الجهل والشك. ويمكن أن يكون هذا الخطاب دليلاً على عدم الفرق بين العالم والجاهل بالنسبة إلى حكم الله الواقعي، فإنّ مقتضى الجمع بين هذا الخطاب ودليل أصل التكليف أنّ المأمور به هو طبيعة الصلاة وعنوانها إلّا أنّ لها فرداً بحسب حال الاختيار والعلم وهو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط وفرداً بحسب حال الاضطرار أو الشكّ وهو الصلاة الفاقدة للسورة مثلاً، فكما أنّ الأوّل يكون موجباً للإجزاء فليكن الثاني أيضاً مثله.
وعلى کلّ حال لا مانع من القول بإجزاء المأمور به بالأمر الظاهري بحسب مقام الثبوت كما أنّه لا إشكال فيه بحسب مقام الإثبات أيضاً، وقد ظهر وجهه ممّا قدّمناه.
وأمّا ما في بعض الأذهان من تفويت المصلحة في صورة تأدية الحكم الظاهري إلى عدم جزئية شيء مع كونه جزءً للمأمور به.
فيمكن أن يقال في مقام رفعه بأنّ المصلحة كما يمكن أن تكون في ذات المأمور به يمكن أن تحصل فيه بسبب تعلّق الأمر به، فأمر الشارع مثلاً بالصلاة المرکّبة من القيام
ص: 152
والسجود والركوع والتشهّد وغيرها يكون موجباً لحصول مصلحة في الصلاة، كذلك أمره بالصلاة المركّبة من القيام والسجود والركوع غير التشهّد مثلاً، سبب لحصول المصلحة المقصودة منها، ففي کلّ من الصورتين يمكن القول بعدم المصلحة إذا لم يتعلّق الأمر بها.
وبالجملة: فنحن لا نتصوّر معنىً للمصلحة في هذه الموارد إلّا حصول التعبّد وإطاعة المولى، وهذا كما يمكن أن يحصل بإتيان الصلاة في الصورة الاُولى، كذلك لا مانع من حصوله في الصورة الثانية أيضاً، وهذا معنى إيجاد الأمر المصلحة في المأمور به.
ثم إنّه قد تلخّص من جميع ما ذكرناه: أنّه وإن صار كلام المتقدّمين كالعلّامة والمحقّق وغيرهما موجباً لتوهّم تعدّد المأمور به في حال الاضطرار وفي حال الشكّ والجهل ولذلك ذهبوا إلى عدم الإجزاء إلّا في بعض الصور، ولكنّك بعد الإحاطة بما تلوناه عليك وبعد التدبّر في كلماتهم تعرف أنّ مرادهم هو كون المكلّف به في جميع الموارد واحداً إلّا أنّ له أفراداً متعدّدة، فالمكلّف إذا أتى بما هو فرد للمأمور به أجزأ عنه، سواء كان ذلك الفرد فرداً له في حال الاضطرار أو الاختيار أو في حال العلم أو الجهل.
فمرادهم من الإجزاء أنّ المأمور قد أتى بما هو فرد للطبيعة المأمور بها، لأنّ المستفاد من قوله تعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أوْ رُكْبَاناً...﴾((1)) الآية؛ وقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا...﴾((2)) الآية؛ وقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «كلّ شيءٍ نظيف...» الحدیث؛((3)) وقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «كلّ
ص: 153
ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو»؛((1)) وغيرها أنّ الصلاة المأتيّ بها في جميع هذه الأحوال ولو كانت فاقدةً لجزءٍ أو شرطٍ هي فرد للصلاة المأمور بها.
هذا تمام الكلام في مبحث الإجزاء. والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على خير خلقه أجمعين محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
ص: 154
الفصل الرابع: في مقدّمة((1)) الواجب
لا يخفى عليك: أنّ عنوان النزاع في مقدّمة الواجب في كلمات القدماء من
ص: 155
الاُصوليين هو: أنّ الآمر إذا أمر بشيءٍ وكانت له مقدّمات بها يحصل ذلك الشيء - بمعنى أنّ هذه المقدّمات واقعةٌ في طريقه وتكون من أجزاء علّة حصوله - فهل يلزم من أمره هذا، الأمر بتلك المقدّمات؟ بحيث لو كانت لفعل مقدّماتٌ كثيرةٌ تكون کلّ واحدة منها واجبة مضافاً إلى وجوب هذا الفعل أو لا؟
ولا يخفى عليك: أنّه بناءً على هذا لا يكون النزاع فرعياً، بل لأنّه يرجع إلى وجود الملازمة بين وجوب شيءٍ ووجوب مقدّماته لا يكون إلّا اُصوليّاً.((1))
وحيث رأى المتأخّرون أنّ الالتزام بوجوب جميع المقدّمات في عرض وجوب ذي المقدّمة ممّا لا ينبغي الذهاب إليه قسّموا الواجب إلى النفسي والغيري تارةً، وإلى الأصلي والتبعي تارةً اُخرى. وأثبتوا للمقدّمة نحواً من الوجوب المساوق مع القول بعدم الوجوب.
والظاهر أنّ تطويل البحث في المقدّمة كما هو دأب المتأخّرين قليل الجدوى إلّا أنّ الاقتفاء لأثرهم لمّا لم يكن خالياً عن كثير فائدة - لأنّ بعض المباحث الّتي تعرضوا لها من حيث هي تعدّ من المباحث العلمية المفيدة - فلا ينبغي طيّ المقال وتركها، فعلينا أن نسلك سبيلهم بحسب الوسع بعون الله تعالى، وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم اُمور:
يظهر ممّا ذكرناه في موضوع علم الاُصول((2)) أنّ هذه المسألة ليست اُصولية، وإنّما هي من المبادئ الأحكامية، فلا حاجة لإعادة الكلام فيها.
ص: 156
بدأ الاُصوليون في طرح هذا البحث بذكر أقسام المقدّمة، ولعلّه لذكرها في عنوان المسألة بأنّ المقدّمة واجبة أم لا؟ فتعرّضوا أوّلاً لبيان معنى المقدّمة وأقسامها، ثم لبيان أقسام الواجب، ثم دخلوا في أصل البحث.
ولا يخفى: أنّ المناسب في مقام التسمية تسميتها بالمتقدّمة، لأنّ مرادهم بالمقدّمة ما لها تقدّم على شيء آخر، إلّا أنّه يمكن أن تكون تسميتها بالمقدّمة لأجل الإشارة إلى أنّ أصل ذاتها موجب للتقدّم.
وكيف كان، تنقسم المقدّمة إلى أقسام:((1))
منها: الداخلية والخارجية
والمراد بالاُولى: الأجزاء المأخوذة في ماهية المأمور به. وبالثانية: الاُمور الخارجة عن ماهيته ممّا يتوقّف وجود ذي المقدّمة عليها. وقد استشكل في مقام تصوير المقدّمات الداخلية بأنّ المقدّمية نسبة متضایفة محتاجة إلى طرفين أحدهما المقدّمة والآخر ذي المقدّمة. وبعبارة اُخرى: احتياج ذى المقدّمة إلى المقدّمة إضافة لها طرفان: المحتاج إليه وهو المقدّمة، والمحتاج وهو ذو المقدّمة، فلا يعقل أن تكون أجزاء المرکّب مقدّمة للمركّب والحال أنّه ليس إلّا نفس الأجزاء بأسرها وإلّا لزم احتياج الشيء في الوجود إلى نفسه.((2))
والظاهر أنّ هذا الإشكال مأخوذ من الإشكال المعروف من أهل المعقول بالنسبة
ص: 157
إلى العلّة التامّة، وبيانه: أنّ من المعلوم أنّ المعلول مغاير لعلّته وممتاز عنها فلا يعقل اتّحادهما معاً، والحال أنّ المادّة والصورة من أجزاء العلّة وهما متّحدتان مع المعلول بل عينه، فيلزم تقدّم الشيء وتوقّفه على نفسه، وهذا هو الدور المحال.
وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني(قدس سره) بأنّ المقدّمة ليست إلّا نفس الأجزاء بالأسر وهي الأجزاء الملحوظة من حيث التألّف والاجتماع بلا شرط - على نحو عدم الاعتبار لا اعتبار العدم - بحيث تكون بالحمل الأوّلي غير مجتمعة ولا مؤتلفة، وتكون بالحمل الشائع مجتمعة ومؤتلفة في مقابل الأجزاء الملحوظة بشرط الاجتماع والتألّف والتركّب الحقيقي أو الاعتباري وهو ذو المقدّمة.
هذا، ويمكن أن يقال: إنّ المقدّمة تكون کلّ فرد فرد من الأجزاء كالتكبير والقراءة والركوع، فالتكبير مقدّمة والقراءة مقدّمة والركوع مقدمة.
لا يقال: إذا كان هذا الجزء مقدّمة وذلك الجزء الآخر أيضاً مقدّمة وهكذا، فجميع الأجزاء تكون مقدّمة ويعود الإشكال.
لأنّه يقال: إنّ جميع الأجزاء على هذا مقدّمات، لا مقدّمة.
وبالجملة: في المرکّبات الاعتبارية يتعلّق لحاظ الآمر بجميع الأجزاء ويعتبرها واحداً، ثم يأمر المكلّف بإتيان هذا الواحد الاعتباري، فيكون التكبير مقدّمةً له والركوع مقدّمة اُخرى. ولا يلزم من ذلك كون جميع الأجزاء مقدّمةً، بل كون الأجزاء مقدّماتٍ، وذو المقدّمة هذه المقدمات الّتي لها وحدة اعتبارية من جهة أنّ الآمر لاحظها واعتبرها واحداً.
ومن هنا يظهر ما في كلام المحقّق الخراساني(قدس سره) في دفع الإشكال حيث قال: بأنّ المقدّمة نفس الأجزاء بالأسر، وذو المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع، فالمغايرة حاصلة بينهما.((1))
ص: 158
لأنّ المغايرة بين المقدّمة وذيها لا تكون اعتبارية بل تكون حقيقية وما أفاده كافٍ في دفع الإشكال لو كانت المغايرة بينهما اعتبارية، هذا.
وأمّا الوجوب المتعلّق بکلّ جزء من الأجزاء، أي المقدّمات الداخلية، فلا ريب في نفسيته، وذلك لأنّ المرکّب إذا كان واجباً بالوجوب النفسي فكلّ جزء من أجزائه يكون واجباً كذلك أيضاً لا محالة وملوّناً بهذا اللون، لأنّ المرکّب ليس إلّا تلك الأجزاء.
ولا يبقى بعد كون کلّ جزء من أجزاء المرکّب واجباً بوجوبه النفسي مجالٌ للوجوب الغيري؛ إذ الوجوب إنّما يترشّح من ذي المقدّمة إلى المقدّمة إذا لم تكن المقدّمة واجبة.
ومن هنا يظهر فساد القول بالوجوب النفسي والوجوب الغيري معاً.((1)) وإن كان أضعف الاحتمالات في المقام احتمال وجوب الأجزاء بالوجوب الغيري، لأنّ الأجزاء - وهي نفس الكلّ - لو كانت واجبة كذلك لزم أن لا يكون لنا واجب بالوجوب النفسي، فكيف يتولّد منه ذلك الوجوب الغيري؟ فتدبّر.
ومنها: العقلية و العادية والشرعية
أمّا المقدّمة العقلية، فهي: ما يمتنع وجود ذيها بدونها.
وأمّا الشرعية، فقد توهّم أنّها كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإنّ الصلاة بنفسها قابلة للتحقق والوجود ولو بدون الطهارة، إلّا أنّ الشارع لمّا جعل الطهارة شرطاً لها فلا تتحقق شرعا إلّا بها.
ولكن لا يخفى: أنّه لا يكاد أن تنال يد الجعل المقدّمية وعدمها. فلا يمكن للشارع أن يتصرّف في مقدّمية شيءٍ لشيء بجعله مقدّمة له أو نفيها عنه، فلو كان شيء مشروطاً بشيء واقعاً فلا ينقلب عمّا هو عليه بسبب تصرف الشارع فيه، فإلغاؤه تلك الشرطية لا يصير سبباً لحصوله من دون ذلك الشرط.
ص: 159
نعم، يمكن للشارع أن يأمر بعنوانٍ يصدق على هذه الأفعال الخارجية المخصوصة الّتي من ضمنها الطهارة فلا يصدق على غيرها، من غير أن يأخذ شيئاً شرطاً للمأمور به. فعدم انطباق عنوان المأمور به على تلك الأفعال من غير طهارة محفوظ وباقٍ على حاله من دون حاجة إلى اشتراط شيء فيه أو جعله مقدّمة له.
وأمّا تقييد المأمور به بقيد أو شرط شرعاً بحيث يستحيل تحقّقه بدونه، فهو راجع إلى القسم الأوّل أي المقدّمة العقلية. وعلى کلّ حال ليس للمقدّمة الشرعية معنى محصّل.
وأمّا العادية، فقد توهّم أنّها كالصعود على السطح فإنّه لا يمكن عادة إلّا بنصب السلّم وإن كان يمكن عقلاً بالطيران.
ولا يخفى ما فيه؛ لأنّ الصعود على السطح بالنسبة إلى غير المتمكن من الطيران ممتنع عقلاً إلّا بتوسّط نصب السلّم وأشباهه، فهي راجعة إلى العقلية أيضا.
ومنها: مقدّمة الوجود، والصحّة، والوجوب، والعلم
أما مقدّمة الوجود، فهي ما يتوقّف عليها وجود ذيها بمعنى استحالة وجوده إلّا في ظرف وجودها كنصب السلّم بالنسبة إلى الكون على السطح.
وأمّا مقدّمة الصحّة، فهي الّتي يمكن وجود ذيها بدونها لكن صحّته متوقّفة عليها، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.
وأمّا مقدّمة الوجوب، فهي ما يتوقّف عليها وجوب ذيها.((1))
وأمّا مقدّمة العلم، فهي ما يتوقّف عليها العلم بحصول الواجب، كإدخال شيءٍ أزيد ممّا بين قصاص الشعر وطرف الذقن في غسل الوجه طولاً، وشيء أزيد ممّا دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً لتحصيل العلم بغسل المقدار الواجب. وكالوضوء من الإناءين المعلوم كون أحدهما مضافاً لتحصيل العلم بحصول الوضوء بالماء المطلق.
ص: 160
ولا يخفى عدم وجود فائدة في هذا التقسيم؛ وذلك لأنّ مقدّمة العلم لا تكون ممّا يتوقّف عليها وجود الواجب، فلا يمكن ترشّح الوجوب عليها من قبل وجوب ذيها؛ لأنّ من الممكن الوضوء من أحد الإناءين المشتبهين واتّفاق كونه الماء المطلق. فالقول بوجوب الوضوء منهما لا يكون من جهة المقدّمية المقصودة، بل من باب حكم العقل بالوضوء منهما إرشاداً لتحصيل العلم بالبراءة.
وأمّا مقدّمة الوجوب، فخارجة عن محلّ النزاع أصلاً؛ لأنّ ذي المقدمة لا يتصف بالوجوب قبل وجودها حتى يترشّح عليها وجوبه، وبعد وجودها لا يعقل ترشّح الوجوب عليها، لأنّه تحصيل الحاصل.
وأمّا مقدّمة الصحّة، فإن قلنا في باب الصحيح والأعمّ بوضع ألفاظ العبادات للصحيح فلا ريب في رجوعها إلى مقدّمة الوجود. وأمّا إن قلنا بوضعها للأعمّ فالمقدّمة تكون مقدّمة لوجود الواجب بالحمل الشائع، فلا يتحقّق الواجب بدونها، فترجع بناءً على الأعمّ أيضاً إلى مقدّمة الوجود.
ومنها: المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة
تنقسم المقدّمة بتقسيم آخر إلى المقدّمة الحاصلة قبل وجود ذيها، وإلى المقدّمة المقارنة، له وإلى المقدّمة المتأخّرة عنه.
وحيث إنّ المقرّر في محلّه عدم إمكان تقدّم المعلول على العلّة لا رتبة ولا زماناً بل اللازم وجوب تقدّمها على المعلول تقدّماً طبعياً أشكل الأمر في المتأخّرة بل في المقدّمة المتصرّمة حين وجود ذيها أيضاً؛ لأنّ من الواضح لزوم تقارن العلّة والمعلول زماناً في الوجود وإلّا فتبطل العلية والمعلولية والمسانخة بينهما.((1))
وأفاد في الكفاية في دفع الإشكال - بعد تقسيمه الموارد الّتي توهّم انخرام
ص: 161
القاعدة العقلية فيها إلى ما كان المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتكليف، وإلى ما كان شرطاً للوضع، وإلى ما كان شرطاً للمأمور به - ما حاصله: إنّ كون شيءٍ شرطاً للتكليف متقدّماً عليه أو متأخّراً عنه، مثل القدرة على المأمور به حين الفعل، ليس معناه كون وجوده الخارجي شرطاً، بل المراد لحاظه ووجوده ذهناً. فالآمر في مقام التكليف إذا لاحظ قدرة المكلّف حين الإتيان بالفعل صحّ منه التكليف والأمر. فشرط التكليف متقدّماً كان أو متأخّراً أو مقارناً ليس إلّا لحاظه ووجوده الذهني المقارن مع المشروط.
أمّا كون الشيء شرطاً للمأمور به، فليس معناه إلّا أنّ الآمر يعتبر وينتزع بسبب إضافة المأمور به إلى ذلك الشيء وتعقّب ذلك الشرط له عنواناً منه يكون بذلك العنوان حسناً ومتعلّقاً للغرض.
كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضع، كالإجازة بالنسبة إلى العقد الفضولي فإنّ معنى شرطيتها له ليس إلّا أنّ لحاظها متأخّراً عنه موجب لصحّة اعتبار الملكية وانتزاعها من العقد. هذا ملخّص ما أفاده(قدس سره).((1))
وأمّا تحقيق الحقّ في المقام فسيجيء في نهاية البحث عن التقسيم الآتي للمقدّمة، إن شاء الله تعالى.
ومنها: تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمُعِدّ
ص: 162
قسّموا المقدّمة بلحاظ آخر إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمعدّ.
فالأوّل: ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم.((1))
والثاني: ما يلزم من عدمه عدم ذي المقدّمة، ولا يلزم من وجوده وجوده.
والثالث: ما يلزم من وجوده عدمه.
والرابع: ما يلزم من وجوده وعدمه وجوده.
وبعبارة اُخرى: إذا كان الشيء مؤثّراً في وجود شيءٍ آخر، وكان منه وجود ذلك الشيء، نسمّيه بالسبب.
وإذا كان وجوده موجباً لحصول قابلية الوجود للشيء، نسمّيه بالشرط.
وإذا كان عدمه موجباً لحصول تلك القابلية، نسمّيه بالمانع. فعدمه مقدّمة لحصول ذي المقدّمة.
وإذا كان وجوده وعدمه موجباً لهذه القابلية كالأقدام بالنسبة إلى الكون في المسجد، نسمّيه بالمعدّ.
لا يخفى: أنّه على مسلك أهل المعقول يكون المعدّ وعدم المانع راجعاً إلى الشرط؛ لأنّ الشرط على اصطلاحهم هو الفاعل الّذي يكون به الوجود في مقابل المقتضي الّذي يكون منه الوجود. وهو إمّا من متمّمات فاعلية الفاعل، أو من مصحّحات قابلية القابل. كما أنّ السبب المذكور في كلام الاُصوليين يكون أخصّ من السبب المذكور في عرف أهل المعقول؛ لأنّ السبب على اصطلاحهم يطلق على المقتضي وما يكون منه
ص: 163
الوجود سواء أثّر في المسبّب وأوجده أم لم يوجده لفقدان شرطٍ من شرائط وجوده. وأمّا على اصطلاح الاُصوليّين فالسبب هو المقتضي المؤثّر في الوجود، أي العلّة التامّة، ولذا مثّلوا له بحركة اليد لحركة المفتاح.
وعلى کلّ حال، تعريف الاُصوليين للمعدّ بأنّه ما يلزم من وجوده وعدمه الوجود لا يخلو عن المناقشة؛ لأنّ المعدّ مثل وضع الأقدام ورفعها للكون في المسجد لا يكون إلّا وجوداً واحداً، لأنّه حركة واحدة كسائر الحركات، فكما أنّ الحركة في الكمّ والكيف وفي الجوهر - على القول بها - لا تُعدّ وجوداً وعدماً بل تكون حركة واحدة ووجوداً واحداً، كذلك وضع القدم ورفعه لا يكون إلّا حركة واحدة ووجوداً واحداً كما لا يخفى.
يظهر من مثالهم بحركة اليد والمفتاح للمقدّمة السببیّة في الأفعال التوليدية أنّ مرادهم بالسبب ما كان متعلّقاً لاختيار العبد. ولا يخفى أنّه بعد الاعتراف بأنّ حركة اليد - وهي العرض القائم بوجود اليد - وجودها غير وجود حركة المفتاح - وهي العرض القائم بوجود المفتاح - وأنّ لازم ذلك كون الإيجاد أيضاً متعدّداً، لأنّ الإيجاد والوجود واحد ولا فرق بينهما إلّا أنّ الوجود إذا نسب إلى الفاعل يقال له الإيجاد، ومن دونها يقال له الوجود، يكون صدق السبب والمسبّب على مثل حركة اليد وحركة المفتاح موقوفاً على تعدّد جهة صدورهما من الفاعل، وأمّا لو قلنا بأنّ الصادر منه لا يكون إلّا واحداً ولم يصدر من الفاعل غير فعل واحد وعمل واحد، فلا يصحّ أن يقال بترشّح الوجوب من أحدهما إلى الآخر. فصدق المقدّمة السببیّة في الأفعال التوليدية يتوقّف على صدق تعدّد صدور الفعل من الفاعل.
ص: 164
الأمر بالمسبّب في الأفعال التوليدية((1))
لا يخفى عليك: أنّ النزاع في وجوب المقدّمة السببیّة لا يصحّ إلّا بعد الفراغ عن النزاع في أنّ الأوامر المتعلّقة بالمسبّبات ظاهراً تكون متعلّقة بها واقعاً ولُبّا أيضاً أو أنّها بحسب الواقع متعلّقة بالأسباب، فعلى القول الأوّل يأتي النزاع في وجوب السبب من باب المقدّمية، وأمّا على القول الثاني فلا مجال للنزاع المذكور.
بيان ذلك: أنّ القوم اختلفوا فيما إذا تعلّق الأمر بالمسبّب ظاهراً في أنّ متعلّقه هل هو المسبّب حقيقة، أو هو السبب وإن كان متعلّقه ظاهراً هو المسبّب على أقوال:
أحدها: وجوب المسبّب مطلقاً.((2))
ثانيها: وجوب السبب مطلقاً.((3))
ثالثها: التفصيل((4)) بين ما إذا كان بين السبب والمسبّب فاعل بالطبع أو الإرادة كما في صورة الأمر بإلقاء شخص في النار للإحراق أو إلقائه إلى السبع، وبين ما لم يكن كذلك بل كان صدوره منه بلا واسطة شيءٍ من هذا القبيل. فعلى الأوّل يكون الأمر بالمسبّب كالإحراق مثلاً أمراً بالسبب وهو الإلقاء لا محالة، لأنّ الإحراق أو الإتلاف فعل النار والسبع، فلا يتعلق الأمر به واقعاً. وعلى الثاني
ص: 165
يكون الأمر متعلّقاً بالمسبب واقعاً كما هو متعلّق به ظاهراً. وعلى هذا يتّجه النزاع في المقدّمة السببیّة.
ولكنّ التحقيق هو: أنّ متعلّق الأمر ليس إلّا نفس المسبّب؛ وذلك لأنّ ما استدلّوا به لرجوع الأمر إلى السبب ومنع رجوعه إلى المسبّب: إمّا أنّ التكليف لا يتعلّق إلّا بالمقدور والمسبّب ليس بمقدور.((1))
فجوابه: أنّ المقدور بالواسطة مقدورٌ.
وإمّا أنّ الأمر لا يتعلّق إلّا بما هو فعل للمكلّف والمسبّب ليس فعلاً له؛((2)) لأنّه لو كان فعله، لما انفكّ عنه في بعض الأحيان، كما إذا رمى سهماً ومات الرامي بعد رميه فأصاب شخصاً، فلو كان القاتل والفاعل هو الرامي لما جاز حصول القتل والفعل بعد موته، لاستحالة انفكاك المعلول عن علّته زماناً فهذا كاشفٌ عن عدم كون الرامي وأمثاله - فيما كان من هذا القبيل - فاعلاً بل الفاعل هو السهم.
فجوابه: أنّ الأمر لا يصدر من المولى إلّا لأن يكون داعياً وباعثاً نحو الفعل المأمور به، وأن يبعث العبد إلى إرادة المأمور به أو إلى ما يتوصّل بسببه إليه، فإذا كان ذلك ملاك الأمر فلا مانع من تعلّق الوجوب بالمسبّب.
ويظهر من كلمات الاُصوليين سيّما المثال الّذي مثلّوا به في المقام أنّ النزاع في المقدّمة السببیّة واقع فيما إذا كان السبب والمسبّب من الأفعال التوليدية، بمعنى عدم توسّط إرادة اُخرى بين السبب والمسبّب. ولا يكون في البين غير إرادة المكلّف المتعلّقة بالسبب، كما إذا رمى شخصاً بسهمٍ فأصابه وخرق قلبه فمات ذلك
ص: 166
الشخص، ففي مثله وإن كان للموت وجود ولخرق قلبه أيضاً وجود مستقلّ وللإصابة أيضاً وجود وللرمي وجود كذلك وهكذا، وكذلك لکلّ من هذه الوجودات إيجادٌ خاصّ؛ لاتّحاد الإيجاد والوجود لما مرّ من أنّ الفرق بينهما ليس إلّا أنّه إذا نسب ما وجد إلى فاعله وموجده يسمّی بالإيجاد، وإذا نسب إلى نفسه يسمّی بالوجود. ولكن متعلّق الإرادة لا يكون إلّا الرمي. وأمّا الإصابة المترتّبة عليه والخرق المترتّب عليهما والموت المترتّب عليها فغير متعلّقة للإرادة، غير أنّه بيّنّا أنّه لا مانع من تعلّق الأمر بالمسبّب حقيقة.
فإن قلت: إنّ الأمر لابدّ وأن يتعلّق بما هو فعل للمكلّف.
قلت: يكفي في ذلك انتسابه إليه، فكما يصحّ أن يقال: إنّه رمى، يصحّ أن يقال: إنّه خرق وإنّه قتل، هذا.
وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ السبب على مذاق الاُصوليّين هو ما كان من قبيل الرمي بالنسبة إلى القتل، وفي مثله لا يلزم تقارن السبب والمسبّب زماناً. وهذا بخلاف ما لو اُريد من السبب العلّة الموجدة وفاعل الشيء الّذي يكون منه الوجود؛ لأنّه يلزم منه تقارن العلّة والمعلول زماناً قطعاً، لعدم إمكان تحقّق ضرورة الإيجاب للعلّة من دون تحقّقها للمعلول. وإذا كان الحكم بالنسبة إلى السبب على ذوق الاُصوليين هكذا، فما ظنّك بالشرط؟
إنّ شرائط التكليف في الحقيقة: قيود وأوصاف ترجع إلى المكلّف أو المكلّف به، فتخرج عن دائرة الحكم والتكليف وتدخل في دائرة الموضوع، ولا شبهة في تأخّر الموضوع عن الحكم وجوداً، ولكنّه مقارن له حين الحكم عليه بالإمكان. فلا يصحّ
ص: 167
تكليف المولى عبده إلّا بعد إحراز وجودها تصوّراً في المكلّف، وهي مثل القدرة والعقل والبلوغ من الشرائط العامّة. ولازم وجودها إمكان التكليف والبعث من قبل المولى.
وبعبارة اُخرى: شرط التكليف قيد في المكلّف أو في المأمور به ووصف فيهما يوجب وجوده صحّة حمل المحمول على الموضوع في قضيّة: «التكليف ممكن».
بعد ما عرفت من أنّ الشرط قيد ووصف للمكلّف أو المكلّف به تعرف بأنّه بناءً على ما حقّقناه لا يلزم منه تقارن الشرط والمشروط زماناً بل من الممكن تقدّمه على المشروط (والتكليف) وتأخّره عنه؛ لأنّه لا يكون علّة للوجود، بل موجب لصحّة انتزاع إمكان التكليف. وأمّا ما يلزم تقارن وجوده مع المشروط زماناً فهو العلّة الموجدة للشيء، هذا بالنسبة إلى شرط التكليف.
وأمّا شرط المأمور به فكون شيء شرطاً فيه يمكن أن يكون على أنحاء:
أحدها: أن يكون المراد من شرطية شيءٍ فيه كون المأمور به مقيّداً به على نحو يكون القيد خارجاً والتقيّد داخلاً، كما في صورة الأمر بالصلاة مقيّدة بالوضوء، أو الأمر بإتيان المرأة الصوم مقيّداً بالغسل.((1)) ففي مثل هذا الفرض لا مانع من تقدّم الشرط أو تأخّره عن المشروط، فكما أنّ من الممكن أن يأخذ الشارع شيئاً قيداً للمأمور به مقارناً له، كذلك لا مانع من أخذ شيءٍ متأخّرٍ عن المأمور به أو متقدّمٍ عليه قيداً له. فإذا أتى المأمور بالأمر المتقدّم أو المتأخّر مع نفس المأمور به فقد أتى بما هو وظيفته، وإلّا فلا.
ص: 168
ثانيها: أن يكون المراد من شرطية شيء في المأمور به دخله في انتزاع عنوانه الاعتباريّ وانطباقه على معنونه. فمعنى شرطيّة ذلك الشيء له عدم اعتبار ذلك العنوان وانتزاعه إلّا في ظرف وجود هذا الشيء مقارناً له أو متقدّماً عليه أو ملحوقاً به، فالصوم المأمور به مثلاً أمر انتزاعي اعتباري لا ينتزع من هذه الإمساكات المخصوصة إلّا في ظرف لحوق الغسل به، والشارع لا يعتبر ذلك إلّا على هذه الكيفية.
ثالثها: أن يكون الشرط دخيلاً في وجود المشروط. وهذا هو الّذي لا يمكن تأخّره عن المشروط بل اللازم تقدّمه عليه تقدّماً وجوبيّاً، فيتقدّم عليه طبعاً ويقارنه زماناً لو كان من الزمانيات. وأمّا إذا كان من المجرّدات فلا يتصوّر فيه التقارن الزماني وعدمه. وكأنّه في الكفاية جزم بلزومه مطلقاً.
وأمّا تقدّمه عليه بنحو إذا فرض ضرورة وجود الشرط فرض ضرورة وجود المشروط، وبعبارة اُخرى: تقدّمه عليه تقدّماً إيجابياً فلا يلزم؛ لأنّ ذلك التقدّم لا يكون إلّا في العلّة التامّة وما منه وجود الشيء، هذا.
ولا يخفى عليك: أنّه على النحوين الأوّلين يكون القول بوجوب الشرط وجوباً غيرياً مقدّمياً وهو بعيد عن الصواب؛ لأنّ القيد في القسم الأوّل واجب بوجوب المقيّد، فكما أنّ ذات الصلاة واجبة يكون قيدها أيضاً واجباً. وهذا نظير تعلّق الأمر بمركّب ذات أجزاء، فكلّ واحد من هذه الأجزاء واجب بالوجوب النفسي. وهكذا الكلام في القسم الثاني؛ فإنّ الأمر المتعلّق بالعنوان الاعتباري إنّما هو متعلّق بمنشأ انتزاعه سواء كان منشأ انتزاعه شيئاً واحداً أو مركّباً. هذا تمام الكلام في تقسيمات المقدّمة.
ص: 169
للواجب أقسام بحسب تقسيمات مختلفة:
منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط
إعلم: أنّه قد عرّف الواجب المطلق والمشروط بتعاريف((1)) لا يهمّنا البحث عنها وتطويل البيان في ما قيل أو يمكن أن يقال في نقضها وإبرامها، ونخبة القول فيه ما أفاده في الكفاية وهو: أنّ الواجب إذا لوحظ مع شيء فإن كان وجوبه مشروطاً به فهو مشروط بالنسبة إلى هذا الشيء، وإن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه، من غير فرق بين أن يكون الشيء المشروط به الوجوب من شرائط الوجود كنصب السلّم للكون على السطح، أو من شرائط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ.
فعلى هذا، لا ريب في أنّ الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيّان للواجب، فيمكن أن يكون الواجب مطلقاً من جهة وبالنسبة إلى شيء، ومشروطاً بالنسبة إلى شيء آخر. وإلّا لو قلنا بأنّ الواجب المطلق هو ما كان وجوبه مطلقاً وغير مشروط بشيء أصلاً، والمشروط ما كان مشروطاً بشيء سواء كان من جميع الجهات مشروطاً أو من جهة واحدة، حتى تكون النسبة بينهما التباين، يلزم منه عدم وجدان واجب مطلق أصلاً؛ ضرورة توقّف کلّ وجوب على شرط من الشروط ولا أقلّ من الشرائط العامّة، هذا.((2))
ص: 170
لا يخفى عليك: أنّ الواجب المشروط كما عن الكلّ((1)) إلى زمان الشيخ الأنصاري(قدس سره) هو ما كان وجوبه مشروطاً. ولا نزاع بين غير الشيخ من الفقهاء - قدّس سرّهم - في أنّ الشرط في الأوامر المشروطة راجع إلى الهيئة. كما هو ظاهر القواعد الأدبية في مثل: «إن جاءك زيد فأكرمه»؛ فإنّه لا يشكّ أحد في أنّ المعلّق على المجيء جملة أكرمه لا مادّة الإكرام. ولهذا قالوا في مبحث مقدّمة الواجب بأنّا لو قلنا بوجوب المقدّمة، فإنّما هو بالنسبة إلى ما يكون مقدّمة الوجود لا ما يكون مقدّمة الوجوب؛ إذ من الواضح عدم وجوب تحصيل الاستطاعة لو قال المولى: إن استطعت فحجّ، لأنّه لا وجوب للحجّ قبل حصول الاستطاعة حتى يترشّح منه الوجوب إلى تحصيل الاستطاعة.
ولكنّ الشيخ(رحمه الله) منع رجوع الشرط إلى الهيئة، وذهب إلى رجوعه إلى المادّة.((2))
ولمّا رأى أنّ هذا - مضافاً إلى كونه على خلاف مختار الجميع - مخالف للقواعد العربية بل القواعد الأدبية مطلقاً وبحسب کلّ لغة، صار بصدد الاستدلال وبيان ما یدلّ على لزوم كون الشرط قيداً للمادة لبّاً، ثم أشار إلى دقائق أدبيّة ممّا یدلّ على عدم إمكان رجوعه إلى الهيئة، فأفاد لمقصوده الأوّل: بأنّ العاقل بعد التوجه والالتفات إلى شيء إمّا أن تتعلّق به إرادته وطلبه، أم لا. وعلى الأوّل إمّا أن يكون ذلك الشيء مورداً لطلبه مطلقاً، أو على تقدير خاصّ، وذلك التقدير قد يكون من الاُمور الاختيارية، وقد لا يكون. وعلى الأوّل قد يكون ذلك الأمر مأخوذاً في المكلّف به على نحو يكون مورداً للتكليف، وقد لا يكون كذلك. وعلى كلّ حال: فالإرادة والطلب المتعلّق به لا
ص: 171
يمكن أن يكون مشروطاً بشيء، بل المشروط والمقيّد نفس المطلوب لا الطلب. فلا مانع من كون المراد والمطلوب مشروطاً، بمعنى مطلوبيّته في زمان خاصّ أو في ظرف وجود شيء خاصّ. ثم أفاد لمقصوده الثاني، أي امتناع رجوع القيد إلى الهيئة مستفيداً في ذلك من الدقائق الأدبية:
فمنها: أنّ مفاد الهيئة لا يكون إلّا إنشاء الطلب وإيجاده اعتباراً، والإيجاد والإنشاء في عالم الاعتبار لا يمكن أن يكون مشروطاً بشيء، فلا يصحّ أن يقال: إنّي أوجدته بشرط كذا، أو اُوجده وأنشأه إن كان كذا؛ لأنّ الإيجاد مساوق للوجود والتحقّق ولو في عالم الاعتبار، والاشتراط والتقيّد تعليق للتحقّق، فلا يجتمعان.
ومنها: أنّ مفاد الهيئة - الّذي هو الطلب - معنى حرفي، وقد ثبت في محلّه أنّ الوضع في الحروف عامّ والموضوع له خاصّ، فيكون مفاد الهيئة جزئيّاً حقيقيّاً خارجيّاً، وما هو كذلك لا يمكن إطلاقه ولا تقييده، إلّا في عالم التصوّر والتعقّل، وأمّا في عالم الخارج فلا يعقل ذلك، لأنّه يلزم منه انقلاب الشيء عمّا وقع عليه.
وبعبارة اُخرى: إن كان اللفظ موضوعاً لمعنىً كلّي فبإنشائه يوجد ذلك المعنى الكلّي. وأمّا إن كان موضوعاً لمعنىً جزئيّ فبإنشائه يوجد ذلك المعنى الجزئيّ كما فيما نحن فيه، فإنّ الهيئة موضوعة لأفراد الطلب الخارجي فبإنشائها يوجد فرد من الطلب الخارجي الّذي لا يكون إلّا جزئيّاً حقيقيّاً، ومن الواضح عدم إمكان تقييد الفرد الجزئي.((1))
ومنها: أنّ معاني الهيئات كمعاني الحروف معانٍ آليّة وحالات للغير، والإطلاق والتقييد لا يتصوّر إلّا في المعاني المستقلّة.((2))
ثم إنّه(قدس سره) حيث رأى أنّه لو صحّ ما ذكره يرد عليه إشكال وهو: أنّ ما ذكره من
ص: 172
المبنى لا يجتمع مع القول بعدم وجوب تحصيل الاستطاعة في الحجّ وغيره ممّا كان من هذا القبيل كتحصيل النصاب في الزكاة؛ لأنّه بعد فرض إطلاق الوجوب يجب على المكلّف الإتيان بالمأمور به مع تمام قيوده، والحال أنّه(قدس سره) موافق للمشهور في القول بعدم ترشّح الوجوب من الحجّ إلى تحصيل الاستطاعة ومن الزكاة إلى تحصيل النصاب. فأفاد في دفع هذا الإشكال بأنّ المطلوب تارة: يكون حصول مصلحته مطلقاً. واُخرى: يكون حصولها مقيّداً بقيد، وذلك القيد تارة: يكون بحيث لو أتى به المكلّف عن تكليف من المولى وكان انبعاثه بسبب أمر المولى يوجب حصول المصلحة كالصلاة المشروطة بالطهارة، فإنّ المصلحة الصلاتية لا تحصل إلّا إذا أتى المكلّف بالطهارة تعبّداً، وثالثة: يكون القيد على نحو لا تحصل المصلحة إلّا إذا أتى المكلّف بقيد المأمور به لا عن تكليف.
وبعبارة واضحة: المصلحة تارة: تحصل بإتيان المأمور به مع قيده بشرط كون القيد مأموراً به، أيضاً، وتارة: لا تحصل إلّا إذا لم يكن كذلك وإنّما كان القيد غير مأمور به فلو كان القيد مأموراً به لم تحصل المصلحة، وما نحن فيه من هذا القبيل، ففي مثله لا يعقل الوجوب وكون القيد مأموراً به، لأنّه يلزم منه نقض غرض المولى، هذا.
ولا يخفى عليك فساد ما تفصّى به عن الإشكال؛ لأنّ المراد بالقيد لو كان هو الجزء العقلي فهو واجب بالوجوب النفسي المتعلّق بالكلّ. ولو كان المراد به ما يتوقّف عليه المقيّد بأن يكون مقدّمة له، أو يكون ممّا لا ينطبق العنوان المأمور به عليه كالصلاة مثلاً إلّا في ظرف وجوده، فبحسبهما وإن كان يمكن توهّم عدم وجوب القيد، إلّا أنّه بعد فرض الوجوب مطلقاً لا ينبغي توهّم ذلك.
هذا مضافاً إلى أنّ تقييد المأمور به بقيدٍ لا يكون مأموراً به ومشروطيّته بحصول ذلك القيد لكن لا عن تكليف، كلام خالٍ عن الوجه؛ لأنّ تقييد المأمور به بالقيد المشروط
ص: 173
إتيانه عن التكليف حَسَن وموجب لحدوث جهة الحُسن فيه، وأمّا تقييده بالقيد المشروط عدم إتيانه عن التكليف فلا طريق لتصوّر وجه له أصلاً.
وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني(قدس سره) في وجه عدم وجوب المقدّمة المعلّق عليها الوجوب على مختار الشيخ(رحمه الله): بأنّها وإن كانت من المقدّمات الوجودية للواجب إلّا أنّها قد أخذت على نحو لا يكاد يترشّح عليها الوجوب من ذيها؛ فإنّ الآمر قد جعل الشيء واجباً على تقدير حصول ذلك الشرط ومعه كيف يترشّح عليه الوجوب من جانب ذيها ويتعلّق به الطلب، وهل هذا إلّا طلب الحاصل؟((1))
فبعيد عن الصواب؛ لأنّ ما أفاده لا يدفع إشكال لزوم وجوب هذه المقدّمة مع إطلاق الوجوب، إلّا أن يقال برجوع ذلك إلى تقييد الهيئة وهو على خلاف مختار الشيخ(قدس سره)، فتأمّل.
والّذي ينبغي أن يقال: إنّ الملاك والقاعدة لرجوع القيد إلى المادّة لا إلى الهيئة: كون الفعل المقيّد ذا مصلحة أراد المولى حصول تلك المصلحة مطلقاً، ففي هذا الفرض لا يصحّ القيد إلّا برجوعه إلى المادّة.((2))
وأمّا القاعدة والملاك لرجوع القيد إلى الهيئة دون المادّة فعلى أقسام:
منها: أنّ الآمر يطلب فعلاً لدفع أو رفع مفسدة عن المكلّف، لکنّه في ظرف حدوث تلك المفسدة وتوجّهها إليه، فيكون الفعل مطلوباً بنفسه من دون تقييد له بوجود
ص: 174
تلك المفسدة المبغوضة، فدافعيّته عنها ليست مقيّدة بشيء حتى تكون المادّة مقيّدة، وإنّما طلبه ووجوبه - أي الهيئة - مقيّد بحدوث المفسدة. وهذا مثل أن يقول: إن ظاهرت فأعتق رقبة، أو إن فاتتك الصلاة فاقضها، أو إن أفطرت فكفّر؛ فإنّ العتق وقضاء الصلاة والكفّارة موجبة لدفع المنقصة الروحية الحاصلة بسبب الظهار وترك الصلاة وإفطار الصوم ولا تقييد لدافعيّة العتق أو القضاء أو أداء الكفّارة عن هذه المفسدة والمنقصة الروحية، ولكن وجوبها مقيّد بالظهار وترك الصلاة والإفطار.
ومنها: أن يكون الفعل المأمور به ذا مصلحة في جميع الأوقات والأحوال بمعنى سببيّة ذلك الفعل لتحقّق هذه المصلحة كيف ما وقع وأينما وقع، ولكن لأجل وجود المانع لا يمكن البعث إليه إلّا في بعض الموارد. ففي هذا الفرض يكون القيد راجعاً إلى الهيئة لا محالة أيضا، وهذا كاشتراط وجوب الصلاة بالقدرة، فإنّها لو صدرت عن العاجز تكون معراجه وموجباً لقربه، ولكن حيث لا يمكن تحريك العاجز وبعثه نحوها يقيّد الطلب بصورة القدرة، وهكذا بالنسبة إلى التمييز والعقل ونحوهما. وكما إذا كان البعث المطلق نحو الفعل موجباً للعسر كما في الحجّ، فتكون الاستطاعة قيداً للهيئة ولو كان الحجّ ذا مصلحة صدر من المستطيع أو غيره، ولكن حيث إنّ وجوبه على الجميع موجب للعسر فلذلك قيّده الشارع بالاستطاعة. ونحوه وجوب الزكاة، هذا.
إذا عرفت إمكان رجوع القيد إلى الطلب مع إطلاق المطلوب ثبوتاً، يبقى الكلام في مقام الإثبات وفي أنّه هل يوجد في اللغات المتداولة سيّما اللغة العربية الواسعة لفظ يفيد ذلك المعنى أو لا؟ فلو ادّعي إمكان أن يكون لأهل الألسنة سيّما أهل اللسان
ص: 175
العربي مراداً مثل ما ذكر ولم يمكنهم إفادته ولا بيانه، فلا ريب أنّه خلاف الواقع؛ لأنّا نرى بالوجدان أنّ أهل کلّ لغة سيّما العرب يعبّرون في مقام التفهيم - بتوسط الجمل الشرطية - عن مرادهم إذا كان من قبيل ما ذكر. ولو قال لهم قائل بأنّ ذلك محال، لم يقبلوا منه، ويعدّون قوله شبهة في مقابل البديهة وإنكاراً للوجدانيات، فإنّ کلّ أحد يرى من نفسه إمكان إفادة هذا المراد في مقام الإفهام بتوسط إنشاء الجمل الشرطية. وهذا شائع في محاوراتهم واستعمالاتهم من دون أن ينكره أحد. فعلى هذا، لا مجال للاعتناء بالإشكالات المذكورة ودعوى استحالة ذلك؛ إذ كلّها شبهات مقابل البديهة والوجدان. مع أنّ أدلّ دليل على إمكان شيء وقوعه.
ثم إنّه لا يخفى عليك عدم الفرق في ذلك بين قوله: «أطلب منك الإكرام إن جاء زيد» أو «إن جاء زيد فأكرمه».
نعم، الفرق بينهما كما مرّ من جهة أنّ الطلب في الأوّل وقع تحت لحاظ الآمر مستقلّا أي لاحظه باللحاظ الاستقلالي ثم استعمل لفظ الطلب. وأمّا في الثاني فهو مغفولٌ عنه، وملاحظته مندكّة في ملاحظة المطلوب و أنّ الآمر لا يرى إلّا فعل الإكرام، فينشئ لفظ «أكرمه» من غير التفات إلّا إلى تحقّق الإكرام من المطلوب منه. نعم، يرى الإكرام رؤية من اشتاق إليه ويتوجّه إليه توجّه من يطلبه، كما أنّ الإنسان إذا مشى إلى مسجد يكون حين المشي غافلاً عن مشيه ولا يرى إلّا لكون في المسجد.
ويمكن بعيداً أن يكون مراد الشيخ(قدس سره) من عدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة هذا الفرق الموجود بين النحوين من الأمر. وأنّه حيث إنّ الطلب مغفول عنه فلا يمكن تقييده؛ لأنّ إمكان تقييده ملازم لملحوظيته استقلالاً وهي خلاف الفرض. فحيث إنّ الآمر لا يرى إلّا المطلوب، فلابدّ من أن يكون القيد راجعاً إليه.
ولكن لا يخفى عليك أنّ هذا أيضاً في الحقيقة يرجع إلى تقييد الهيئة.
ص: 176
الأوّل: لا ينبغي الارتياب في عدم وجوب مقدّمة الوجوب في الواجب المشروط، وأمّا المقدّمات الوجوديّة فوجوبها لو قلنا بالملازمة تابع في الاشتراط لوجوب ذيها.
الثاني: إنّ مقدّمة الوجوب وما هو شرط للوجوب لا يلزم أن يكون مقدّماً أو مقارناً زماناً للوجوب، بل يلزم أن يكون مقدّماً عليه بالطبع. فعلى هذا، تارة: يكون وجود هذه المقدّمة قبل الوجوب كأكثر المقدّمات الوجودية. واُخرى: يكون بعده. وهذا لا إشكال فيه بناءً على ما سلكه المحقّق الخراساني(قدس سره) في شرائط التكليف،((1)) وعلى ما حقّقناه أيضاً.((2)) والله تعالى أعلم بالصواب، وهو حسبي ونعم الوكيل في المبدأ والمآل، وأسأله التوفيق وحسن العاقبة والخاتمة، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
ومنها: تقسيمه إلى المنجّز والمعلّق
قال في الفصول: إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف، ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدورٍ له، وليسمّ منجّزاً. وإلى ما يتعلّق وجوبه به، ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدورٍ له، وليسمّ معلّقاً كالحجّ؛ فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، ويتوقّف فعله على مجيء وقته، وهو غير مقدورٍ له...،((3)) إلخ.
واستشكل على نفسه بأنّه على هذا لو كان الوجوب فعلياً يلزم تعلّقه بأمر غير مقدورٍ للمكلّف، والحال أنّ القدرة من الشرائط العامّة، فإنّ وجوب الحجّ في شهر ذي
ص: 177
الحجّة لو تعلّق مطلقاً بالمكلّف في شهر ذي القعدة مثلاً، يلزم منه التكليف بما لا يطاق؛ لأنّ الحجّ قبل الموسم غير مقدورٍ له. ولو تعلّق به مشروطاً بمجيء الوقت، فلا وجوب قبله حتى يجب تحصيل الراحلة والزاد.
ودفعه بأنّ ما هو الشرط في صحّة التكليف مقدوريّة المكلّف به في ظرف الامتثال وزمان العمل لا حال البعث والتكليف.
وقد تعرّض أيضاً لإشكال آخر وهو: أنّه لو كان المراد من إطلاق الوجوب قبل الموسم إطلاقه حتى بالنسبة إلى غير القادر ومن يموت قبل الموسم، فهذا تكليف بما لا يطاق. وأمّا إن كان المراد من إطلاقه إطلاقه بالنسبة إلى القادر والواجد للشرط، فإطلاقه مشروط بتحقّق الشرط، فلا يكون وجوباً قبل تحقّق الشرط.
ودفعه بأنّ المراد إطلاق التكليف بالنسبة إلى القادر والواجد للشرط. ولا يلزم منه اشتراط الوجوب بدخول الوقت، بل يمكن أن يكون مشروطاً بأمر اعتباري ينتزع من إدراك المكلّف وقت الامتثال وصيرورته فيما يأتي قادراً، فالشرط كونه بحيث يصير قادراً أو يُدرك الوقت، فالوجوب بذلك الأمر الاعتباري، وهو حاصل قبل دخول الوقت.
وغرضه من ذلك كلّه تصحيح القول بوجوب الأغسال الليلية للصوم، ووجوب تحصيل الزاد والراحلة قبل الموسم للحجّ؛ لأنّه بما أفاد لا مانع من القول بحالية الوجوب في الصوم والحجّ واستقبالية الواجب.
ولا يخفى: أنّ مبنى هذا التقسيم أنّه(قدس سره) تخيّل عدم إمكان تأخّر شرط الوجوب عن الوجوب في الواجب المشروط. ورأى القول بأنّ الحجّ والصوم من الواجبات المشروطة المتداولة، موجب للقول بعدم وجوب مقدّماتهما الوجودية مثل الغسل
ص: 178
وتحصيل الزاد والراحلة، فقسّم الواجب بالاعتبار المذكور حتى يتمّ القول بوجوب الغسل في الليلة السابقة ووجوب السير إلى الحجّ وغير ذلك.
ولا يذهب عليك: أنّ صاحب الفصول(قدس سره) لم يقسّم الواجب إلى المطلق والمشروط والمعلّق بأن يكون المعلّق قسماً ثالثاً في مقابلهما، حتى يقال: إنّ تقسيمه إلى المطلق والمشروط أمره دائر بين النفي والإثبات، فيلزم من تقسيم الفصول ارتفاع النقيضين وهو محال، بل ما يظهر من الفصول أنّه قسّمه إلى المطلق والمشروط باعتبار، وإلى المعلّق والمنجّز باعتبار آخر.
وكذا لا مجال للقول بأنّه(قدس سره) قد جعل المعلّق قسماً من المطلق؛((1)) لأنّ من الواضح كون المعلّق قسماً للمشروط. وإنّما الفرق بين هذا وسائر أقسام المشروط: أنّ الشرط في المعلّق أمر اعتباريّ موجود في الحال، وهو كونه بحيث يدرك الموسم أو يفي عمره بإدراك الوقت، بخلاف سائر أقسام المشروط؛ فإنّ الشرط فيها لا يتحقّق إلّا بتحقّق زمان الواجب.
فظهر بزعمه(قدس سره) أنّ المعلّق يكون من المشروط وافتراقه مع سائر أقسام المشروط في اعتبارية الشرط فيه ووجوده في عالم الاعتبار قبل مجيء وقت الواجب، هذا.
ولكن لا فائدة لهذا التقسيم ولو سلّم أنّ الاُمور الاعتبارية يمكن أن توجد قبل وجود منشأ اعتبارها (مع أنّ التحقيق أنّ الأمر الانتزاعي الاعتباري لا يتحقّق إلّا بتحقّق منشأ انتزاعه)، لأنّا قد حقّقنا((2)) جواز تأخّر شرط التكليف، عنه. ومراد صاحب الفصول(رحمه الله) من هذا التقسيم تصحيح القول بوجوب بعض المقدّمات،
ص: 179
والتفصّي عن الالتزام بوجوب المشروط قبل تحقّق شرطه كوجوب السير إلى الحجّ قبل مجيء ذي الحجّة، فلو قلنا بوجوب السير قبل ذي الحجّة من جهة وجوب الحجّ يلزم تحقّق وجوب الحجّ قبل شرطه - وهو مجيء ذي الحجّة - .
وقد عرفت في ما مضى إمكان ذلك بناءً على القول بجواز تأخّر الشرط عن المشروط، وأنّ أمثال ذلك كثير في الشرعيات، ولا حاجة للتفصّي عن الإشكال المتوهّم فيها إلى التقسيم المذكور.
ومن هنا يظهر عدم لزوم المحال لو التزمنا بقول صاحب الفصول(قدس سره)، كما زعمه بعضهم. ولو دقّقنا النظر لعلمنا أنّ مقصوده من ذلك لا يكون إلّا بيان إمكان فعلية الإيجاب واستقبالية الواجب. وهذا كلام صحيح عبّر عنه بالواجب المعلّق، وإن شئت عبّر عنه بالواجب المشروط. ولا يمكن الذبّ عن الإشكال المذكور في وجوب السير إلى الحجّ وتحصيل الراحلة إلّا على القول بفعلية الوجوب واستقبالية الواجب. أو القول بأنّ أمثال هذه المقدّمات واجبة بالوجوب النفسي لا بالغير، بل وجوبا نفسياً للغير، كما قد يظهر من بعض الأخبار والآيات الدالّة على وجوب هذه المقدّمات.
ثم إنّه قد حكى في الكفاية إشكالاً عن بعض أهل النظر،((1)) والحقّ في الجواب عنه ما أفاده(رحمه الله) فيه. وأمّا الجواب بأنّ إتيان المقدّمات من باب التهیّؤ لإرادة الفعل فيما بعد،((2)) ففاسد جدّاً؛ لأنّ إرادة المقدّمات إرادات تبعية متولّدة من إرادة أصل الفعل وهي الشوق المؤكّد. والله تعالى يعلم الصواب، وهو الهادي إلى ما هو الحقّ في کلّ باب.
ص: 180
ومنها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي
إنّ المحقّق القمّي(رحمه الله) قسّم الواجب إلى الأصلي والتبعي.((1)) ومراده من الأصلي كما يستفاد من كلامه، هو: الواجب الّذي يحصل وجوبه من اللفظ ويثبت من الخطاب قصداً. وأمّا التبعي فهو: الّذي يكون وجوبه غير مقصود للمتكلّم وإن كان يستفاد وجوبه من اللفظ أيضاً.
فالأوّل كقوله: «إن جاءك زيد فأكرمه»، فإنّ دلالته على وجوب الإكرام عند المجيء مقصود للمتكلّم، وقد قصد من الخطاب ذلك.
والثاني، فمثل ما يستفاد من الآيتين الكريمتين: ﴿وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾؛((2)) و ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً﴾؛((3)) فإنّه يستفاد من لحاظ الآيتين معاً كون أقلّ الحمل ستة أشهر، وأمثال ذلك من دلالات الإشارة. فكون أقلّ الحمل ستة أشهر لا يقصد من اللفظ في الآيتين ولكنّهما تدلّان عليه بالالتزام، هذا.
والّذي ينبغي أن يقال: إنّ محصّل هذا: أنّ الواجب الأصلي هو ما يدلّ اللفظ على وجوبه دلالة أصلية مقصودة للمتكلّم. والتبعيّ ما لم يكن كذلك.
وبعبارة اُخرى: الدلالة الأصلية في جميع الموارد هي: دلالة اللفظ على معناه المقصود للمتكلّم. والدلالة التبعية هي: دلالته على معنى غير مقصود له، ولكن هذا إنّما يتمّ ويصحّ فيما تكون له حقيقة لا من جهة الإنشاء وسببيّته، كأقلّ الحمل. وأمّا مثل البعث والطلب الّذي لا يكون له وجود إلّا بسبب الإنشاء فلا يعقل دلالته عليه تبعاً، فبعد فرض كون تحصّل الطلب بإلقاء اللفظ وإنشائه قاصداً لمعناه لا يمكن تحصّله من غير
ص: 181
أن يتحقّق إنشاء خاصّ كذلك، فلا يمكن دلالة اللفظ عليه تبعاً؛ لأنّ لازمه دلالة اللفظ على المعدوم، والحال أنّ العدم لا يشار إليه ولا يخبر عنه.
ثم إنّه لا يخفى عليك: أنّ هذا التقسيم لا يعقل ولا يكون إلّا بحسب مقام الدلالة والإثبات.((1)) وأمّا بحسب مقام الثبوت فلا يمكن تصوّر تقسيمٍ غير تقسيمه إلى النفسي والغيري، فلا مجال للقول برجوع هذا التقسيم إلى مقام الثبوت.((2))
ومنها: تقسيمه إلى النفسي والغيري
وقد يقال في تعريفهما: بأنّ الواجب النفسي هو الّذي وجب لنفسه. والغيري ما وجب لغيره.
واُورد عليه: بأنّه يلزم من هذا التعريف أن تكون الواجبات الشرعية جلّها بل كلّها سوى المعرفة واجبات غيريّة؛ لأنّها ليست مطلوبة بالذات بل تعلّق الطلب بها من أجل فائدة ومصلحة تترتّب عليها، فالصلاة مثلاً واجبة لأجل أنّها موجبة لحصول القرب وصفاء الروح وغيرهما.((3)) وبعبارة اُخرى: يلزم عدم صدق المعرِّف على کلّ ما صدق عليه المعرَّف.
واُجيب: بأنّ الواجب النفسي هو الواجب الّذي لا تكون فائدته ومصلحته وما اُمر لأجله مأموراً به، لأنّه لا يمكن أن يقع تحت الأمر والتكليف، كالتقرّب إلى الله وحصول الدرجات في الجنة، فإنّ هذه الفوائد ليست اختيارية حتى تقع تحت الأمر.
ص: 182
ولا يخفى ما في هذا الجواب، فإنّ المقدور بالواسطة مقدور، فحصول القرب وإن كان ممّا لا يقدر عليه المكلّف ابتداءً لکنّه مقدور له مع الواسطة.
والأولى أن يجاب عنه: بأنّ الواجب النفسي هو الّذي تعلّق الإيجاب به بنفسه، بحيث يرى العرف تعلّقه به ابتداءً، وإرادة الآمر بإيجابه انبعاث المكلّف لإتيانه نفسه. والغيري ما كان إيجابه غير متعلّق بنفسه بل يكون متعلّقاً في الحقيقة بغيره، فلا يكون البعث إليه إلّا بعثاً إلى غيره وليس طلبه إلّا طلب غيره.
وبعبارة اُخرى: الواجب الغيري هو ما يمكن أن يقال: إنّه واجب باعتبار وليس واجباً باعتبار آخر، فباعتبار أنّ الطلب تعلّق به ظاهراً هو واجب، وأمّا باعتبار أنّ المطلوب ما كان هو في طريقه بحيث لا يرى العرف للطلب المتعلّق به وجوداً مستقلاً هو ليس بواجبٍ.
والحاصل: أنّ النفسي هو الواجب الّذي تعلّق به الوجوب بنفسه لا لأنّه واقع في طريق غيره، والغيري هو الّذي تعلّق به البعث والطلب لا لنفسه ولا بنفسه حقيقة بل من جهة وقوعه في طريق حصول واجب آخر، فالبعث والطلب فيه يكون راجعاً في الحقيقة إلى واجب آخر هو ذو المقدّمة، ووجوب هذا الفعل الواقع في طريقه يكون مندكّاً وفانياً فيه، بحيث إنّ الآمر لا يرى عند إيجابه إلّا الغير وحصول ذي المقدّمة من المكلّف. ولهذا يمكن أن يقال: بأنّه لا وجوب هنا حقيقة ولا طلب واقعاً، وأنّ الأوامر الغيرية أوامر إرشادية صرفة راجعة إلى الأوامر النفسية. ولو لم نقل ذلك، فلا ريب في أنّ نحو وجود الأوامر الغيرية لا يكون إلّا وجوداً مندكّاً في الغير.
إذا شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري؟ فتارة: يكون وجوب الغير مقيّداً بشيء
ص: 183
بمعنى كونه مطلوباً في ظرف وجود شيء أو في زمان خاصّ، فلا إشكال في التمسّك بإطلاق الدليل على وجوب ذلك الواجب مطلقاً كان بذلك الغير واجباً أم لا. وتارة: يكون الغير واجباً مطلقاً وعلى کلّ حال، فتمام الشكّ في الواجب راجع إلى أنّه نفسي أو غيري، وفي هذه الصورة ذهب المحقّق الخراساني(رحمه الله) إلى نفسيّته وجواز التمسّك بالإطلاق لإثبات نفسيّته؛((1)) لأنّ الشكّ واقع في أنّ الواجب هل وجب لأجل الغير أو لا؟ وإطلاق الهيئة يقتضي عدم تقييد وجوبه بذلك.
ولا يخفى ما في جواز التمسّك بالإطلاق في الصورة الثانية؛ لأنّه يلزم منه جواز تقييد المعلول من ناحية علّته فإنّ الواجب الغيري وجوده معلّل بوجود الغير، فلو قلنا بإمكان التمسّك بالإطلاق لإثبات نفسية الواجب - لأنّ كونه غيرياً معناه تقييده بغيره وكونه مترشّحاً منه وهو منفيّ بالإطلاق - يلزم منه وقوع ما هو فى المرتبه السابقة في المرتبة اللاحقة، ووقوع ما هو العلّة في مرتبة المعلول، وبطلانه واضح.
فالنتيجة: عدم الفرق فى الوجوب النفسي والغيري من جهة التمسّك بالإطلاق. وبعبارة اُخرى: وجوب الواجب الغيري معلول لوجوب الواجب النفسي وغير مقيّد بكون غيره واجباً وكونه مترشّحاً منه، بل وجوب الواجب النفسي أي ذي المقدّمة علّة للبعث نحو الواجب الغيري أي المقدّمة، لكن على سبيل الإطلاق وعدم كونه بعثاً مقيّداً بوجوب غيره وإلّا يلزم كون العلّة الّتي هي سبب لوجود المعلول قيداً له وسببا وعلّة لنفسه، فتدبّر جيّداً.
ويمكن دعوى انصراف الهيئة إلى الوجوب النفسي؛ لأنّ العرف لا ينصرف ذهنه عند طلب المولى إلّا إلى نفسيّة طلبه وإرادة المولى انبعاث العبد نحو المبعوث إليه لإتيانه لنفسه.
ص: 184
لا يخفى عليك: عدم استحقاق المكلّف الثواب بسبب موافقته للأمر النفسي، بمعنى أن يكون له مطالبة الثواب والأجر من المولى وقبح منعه من قبل المولى. وهذا من جهة أنّ العبد مِلْك للمولى، فلو أمره المولى بفعل فامتثل وأطاعه لم يكن للعبد طلب الأجر منه؛ لأنّ المولى تصرَّف في ملكه، وعلى العبد امتثال أمره. بل كلّما اشتدّت العبودية اشتدّ قبح طلب الأجر من المولى، فكيف بمن أنشأ العبد وخلقه وصوّره ونعّمه! وأيضاً الأوامر النفسية كلّها ذات مصالح راجعة إلى العبد، والمولى غنيّ عن إطاعته، فقبيح من مثل هذا العبد طلب الأجر منه، كما أنّه يقبح على المريض الّذي عالجه الطبيب وأعاد صحّة بدنه وسلامته إليه، لكن أمره بشرب المسهل ونهاه عن أكل البطّيخ مثلاً، أن يطلب من ذلك الطبيب الأجر على أنّه أطاع أمره وشَرب المسهل وانتهى عن أكل البطّيخ، بل لا يعدّ ذلك إلّا من نقص العقل.
فالثواب والأجر من المولى لا يكون إلّا رحمة وتفضّلاً منه.
وأمّا التعبير بالأجر في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾؛((1)) أو الجزاء، كقوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾؛((2)) أو الثواب، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ﴾،((3)) فإنّما هو لأجل كمال العناية بهداية العبد، كقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً﴾.((4))
ص: 185
فعلى هذا، لا مجال للاعتناء بقول بعض المتکلّمين((1)) من أنّ التكليف تحميل المشقّة والكلفة، فعلى الحكيم إعطاء الأجر للمكلّف. هذا بالنسبة إلى الأوامر النفسية.
وقد اتّضح من ذلك وجه عدم استحقاق الأجر والثواب لو أتى بالأوامر الغيرية ومقدّمات الواجبات النفسية.((2)) نعم، لا مانع من التفضّل من قبله جلّ شأنه.
وأمّا الكلام في استحقاق العقوبة على المخالفة، فلا يخفى أنّ العبد لو خالف أمر المولى فحيث يُعدّ طاغياً عليه وخارجاً عن رسم العبودية يستحقّ العقوبة بذلك، بمعنى أنّ للمولى عقابه. ولو عاقبه فلا يتصوّر قبح في عقابه عبده العاصي، هذا فيما تكون المخالفة مخالفة للواجبات النفسية، أو المحرّمات كذلك.
وأمّا العقاب على ترك المقدّمات ومخالفة الأوامر المتعلّقة بها، فلا مجال له أصلاً؛ لأنّ المخالفة لا تكون إلّا واحدة، فليكن عقابها أيضاً كذلك.
قد اُشكل في الطهارات الثلاث((3)) بأنّ من الواضح كونها من الواجبات الغيرية مع أنّ قصد الامتثال معتبر فيها، وهذا مشعر باستقلالها وأنّ لها امتثالاً مستقلاً، وهذا يتنافى مع غيريّتها ومقدّميّتها.
ص: 186
واُشكل((1)) أيضاً بأنّه كيف يمكن الأمر بإتيانها بقصد الامتثال مع أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى ما هو متعلّقه، فداعوية الأمر نحو الفعل موقوف على قصد الأمر، وقصد امتثال الأمر موقوف على كون الأمر داعياً إلى هذا الفعل، فيلزم منه الدور.
ولا يمكن الجواب عن هذا الإشكال في المقام بما قد يجاب عنه في الواجبات النفسية بتقريب: أنّ من الممكن أن لا يكون قصد الامتثال جزءاً للمأمور به، بل الأمر تعلّق بأصل العمل وعلم من الخارج حصول الإطاعة وتوقّفها على قصد الامتثال، كما عرفت تفصيله في مبحث التعبّدي والتوصّلي.((2)) وأمّا فيما نحن فيه حيث إنّ الأمر الغيري ترشّحي لا يكاد يترشّح إلّا إلى ما هو مقدّمة للواجب، والمقدّمة كما هو الفرض لا تكون إلّا الطهارة مع قصد الامتثال، فلابدّ من تعلّق الأمر الترشّحيّ الغيري بالمقدّمة، وهي نفس العمل مع قصد الامتثال والتقرّب.
ولايمكن التفصّي عن هذا الإشكال بما تفصّى به المحقّق الخراساني(قدس سره) هناك.((3))
وهذا مراد صاحب الكفاية فيما نحن فيه بقوله: «هذا مضافاً إلى أنّ الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصّلياً... إلخ».((4))
وغرضه أنّ الأمر التعبّديّ النفسي على ما عرفت سابقاً - في التعبّدي والتوصّلي - هو الأمر المتعلّق بما هو أوسع من الغرض، وهذا بخلاف الغيري فإنّه لا يتعلّق إلّا بما هو محصّل لذي المقدّمة، فلا يكون إلّا توصّلياً صرفاً. فلا يفيد ذلك الجواب في ما نحن فيه. (ويأتي نظير هذا الإشكال على المحقّق الخراساني(قدس سره) في توجيه الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات إذا تعلّق النذر بهما، في ذيل البحث في الشبهة المصداقية).
ص: 187
والّذي ينبغي أن يقال في الجواب: إنّ إتيان المقدّمات بقصد الامتثال وحصول التقرّب بها لا يكون موقوفاً على الأمر بالمقدّمات، بل إذا أراد المكلّف إتيان ذي المقدّمة بقصد الامتثال والتقرّب تتولّد من تلك الإرادة إرادة ما هو مقدّمته، فيأتي بها لأجل حصول ذيها، وهذا المقدار كافٍ في تحقّق الامتثال وحصول التقرّب.
فلو فرضنا أنّ المكلّف أراد إتيان المقدّمة لكن لا لغرض شهويّ ونفسانيّ بل من جهة أنّه أراد إتيان ذي المقدّمة مع كون إرادته لإتيانه متولّدة من أمر المولى كفى ذلك في الامتثال واستحقّ بذلك الثواب كما يستحقّ بإتيان ذيها.
فلو قام شخص من نومه في الليل مع شدّة البرد وتوضّأ من ماء بارد لصلاة الليل وأدركه الموت قبل الصلاة، وقام شخص آخر في مكان آخر لا تكون برودته بهذه المثابة وتوضّأ وأتى بها، أيجوز عند العقل أن يقال بأنّ الثاني امتثل ولكنّ الأوّل لم يمتثل؟ وهل يجوّز العقل أن یکافئ المولی ويشكر عمل الثاني دون الأوّل؟ هذا.
ولو لم نقل بذلك وقلنا بعدم استحقاق الثواب فالتقرّب والامتثال حاصل على کلّ حال؛ لأنّه لا يتوقّف على ترتّب الثواب. فعلى هذا، لا مانع من إتيان المقدّمة بقصد التقرّب والامتثال من غير تعلّق أمر بها. مع أنّه لو قلنا بتعلّق الأمر بها من جهة مقدّميتها فلا يتحقّق الامتثال بقصد ذلك الأمر بل إنّما يتحقّق لو أراد فعل ذيها ممتثلاً.
نعم، يمكن أن يكون لبعض المقدّمات كالطهارة أمر مخصوص من جهة نفسها، أو أوامر متعدّدة من جهة كونها مقدّمة لواجبات متعدّدة أو مستحبّات مختلفة، فلا مانع من حصول التقرّب والامتثال بقصد الأمر المتعلّق بنفسها أو بسبب قصد الأمر المتعلّق بذيها وإرادتها المتولّدة من إرادة ذيها.
ومن هنا يظهر الجواب عن الإشكال الثاني وهو لزوم الدور، فإنّ المكلّف إذا أتى بالمقدّمة وكانت إرادته لفعلها متولّدة من إرادة ذيها وهذه متولّدة من إرادة امتثال
ص: 188
الأمر كفى ذلك في تحقّق التقرّب وحصول الامتثال. هذا مضافاً إلى أنّنا في مبحث التعبّدي والتوصّلي قد أجبنا عن هذا الإشكال((1)) بعون الله المتعال.
بناءً على ما حقّقناه - من تحقّق الامتثال والتقرّب بفعل المقدّمة إن كانت إرادته متولّدة من إرادة ذيها وكانت إرادة ذيها متولّدة من إرادة امتثال الأمر المتعلّق به - لا يبعد القول بصحّة إتيان هذه المقدّمة ولو لم يتعلّق الأمر الوجوبي بذيها في حال إتيانها، كالوضوء أو الغسل قبل حضور وقت الصلاة. فلو أراد المكلّف امتثال أمر الصلاة في وقتها وتولّدت من إرادته هذه إرادة الوضوء قبل حضور الوقت فلا يبعد القول بصحّته؛ لأنّ هذا المقدار كافٍ في حصول الامتثال والتقرّب.
وبالجملة: لا مانع من توسعة دائرة امتثال المقدّمة بالنحو المذكور مع كون دائرة امتثال ذيها مضيّقة.
هل يعتبر قصد التوصّل بالمقدّمة في وجوبها؟ وهل الواجب منها خصوص الموصلة؟
لا يخفى: أنّ وجوب المقدّمة بناءً على القول بالملازمة غير مشروط بإرادة فعل ذيها وإن كان يظهر من صاحب المعالم(قدس سره) اشتراط وجوبها بإرادة ذيها.((2))
وذلك لأنّ وجوب المقدّمة لا يكون إلّا وجوباً ظلّياً رشحيّاً ولا يتصوّر بناءً على الملازمة وجوب ذي المقدّمة من غير تعلّق الوجوب إلى مقدّمته، فكما لا يمكن وجود
ص: 189
ذي الظلّ مع عدم الظلّ، كذلك لا يمكن وجوب ذي المقدّمة مع عدم وجوب المقدّمة فالمقدّمة، تابعة لذيها في الإطلاق والاشتراط من دون تقييد آخر لها، وهذا واضح لا يحتاج إلى إطالة الكلام. إنّما وقع الخلاف بينهم في متعلّق وجوب المقدّمة وأنّ الواجب هل هو المقدّمة الّتي اُريد بإتيانها التوصّل إلى ذيها فلو لم يقصد من إتيانها هذا لما وقعت على صفة الوجوب، أو أنّ الوجوب تعلّق بمقدّمة يترتّب عليها ذو المقدّمة، فلو لم يترتّب عليها كشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب وعدم كونها متعلّقة له، أو لا يكون شيء منهما معتبراً في تعلّق الوجوب بها؟ وجوه، بل أقوال:
أوّلها: ما هو المنسوب إلى الشيخ الأنصاري(قدس سره) والمحكيّ عن تقريرات بحثه.((1))
وثانيها: مختار صاحب الفصول(رحمه الله).((2))
وثالثها: مختار الكفاية،((3)) وغيرها.
وهناك وجه آخر كما في الفصول وهو: كون متعلّق الوجوب وما يقع متّصفاً بالوجوب خصوص ما قصد به التوصّل إلى ذي المقدّمة مع موصليته إلى ذي المقدّمة.((4))
ولا يخفى عليك: أنّ الوجه الأوّل وإن كان قد نسب إلى الشيخ(رحمه الله) كما توهّم في الكفاية،((5)) ولكن هذا التوهّم إنّما نشأ من عدم التامّل التامّ في كلام صاحب التقريرات؛ فإنّ ما ذكره في هذا المقام (بنحو إن قلت وقلت) صريح في أنّ مراد الشيخ(رحمه الله): توقّف حصول التقرّب بالمقدمة على قصد التوصّل بسببها إلى ذي المقدّمة.
وهذا كلام متين وقد بيّنا وجهه سابقاً. فالمقدّمة إن كانت ممّا لها مطلوبية ونفسية
ص: 190
ومصلحة ذاتية كالوضوء والغسل يحصل التقرّب بفعلها تارة بإرادة أمرها النفسيّ. وتارة اُخرى بإرادة التوصّل بسبب فعلها إلى ذيها وإن لم تكن ممّا لها مطلوبية نفسيّة، فلا يمكن التقرّب بها إلّا بإرادة التوصل بسبب فعلها إلى ذيها. فعلى هذا، يسقط ما أورده المحقّق الخراساني(رحمه الله) في الكفاية على الشيخ(قدس سره).((1))
وأمّا الكلام في أصل المطلب، فلا يكون محتاجاً إلى بيان؛ لأنّ عدم توقّف اتصاف المقدّمة بالوجوب على قصد التوصّل أوضح من أن يخفى، ولا ينبغي توهّم اعتباره لأحد بعد فرض كون المقدّمة ما يتوقّف عليها وجود ذي المقدّمة، وأنّ توقّفه عليها لا يكون إلّا بذات المقدّمة من غير دخل لهذا القصد وعدمه فيه. فالحقّ ما ذهب إليه وأوضحه في الكفاية.
وأمّا الوجه الثاني، وهو: أنّ المقدّمة لا تقع واجبة إلّا إذا ترتّب عليها ذو المقدّمة، ولا تقع على صفة الوجوب لو لم يترتّب عليها ذو المقدّمة. وليس معنى ذلك أنّ الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة مشروط بترتّب ذي المقدّمة عليها، بل معناه أنّ الوجوب مطلق ولكنّ المقدّمة لا تقع على صفة الوجوب إلّا إذا كانت موصلة وترتّب عليها ذيها.
وقد بنى على ذلك في الفصول وجوب المقدّمة المحرّمة الّتي توقّف عليها واجب أهمّ لو ترتّب ذلك الواجب عليها، بخلاف ما لو لم يترتّب عليها ذو المقدّمة فتكون المقدّمة باقية على حالها من الحرمة. فلو أتى بهذه المقدّمة بزعم ترتّب ذيها عليها فاتّفق
ص: 191
عدم ترتّبه عليها فقد ارتكب فعلاً محرّماً، ولكن حيث زعم انطباق الواجب عليها يكون معذوراً ولا يعاقب عليه. كما أنّه لو لم يرتكب المقدّمة مع علمه بتوقف ذيها عليها وظهر فيما بعد أنّه لو فعلها أيضاً لما ترتّب ذو المقدّمة عليها، فليس عليه شيء. نعم، هو متجرٍّ بتركه فعلاً قَطَع بوجوبه.((1))
وفيه: أنّه إن اُريد بالموصلية أنّ للمقدّمة فردين، أحدهما: ما يترتّب عليه ذو المقدّمة وتكون موصلة إليه. والآخر: ما ليس كذلك. وقد تعلّق الوجوب المطلق بالأوّل لا بنحو أن تكون الموصلية قيداً له ويكون متعلّق الأمر مركباً من نفس المقدّمة وموصليّتها، بل الموصليّة لا تكون إلّا عنواناً يشار بها إلى ذلك الفرد، فهذا يرجع إلى أنّ المقدّمة الّتي تعلّق بها الوجوب من قبل ذي المقدّمة ليس إلّا ما يلزم من وجوده وجود ذي المقدّمة ومن عدمه عدمه، وهذا تفصيل بين السبب وغيره أي بين الأفعال التوليدية وغيرها، وقد تقدّم فساد ذلك التفصيل.((2))
وإن اُريد بالموصليّة أنّ الوجوب تعلّق بجميع أفراد المقدّمة لكن بقيد كونها موصلة وترتّب ذي المقدّمة عليها، حتى يكون متعلّق الوجوب: المقدّمة المقيّدة بالموصليّة، فلازم هذا أنّه لو كان لواجب نفسي آلاف من المقدّمات أن يترشّح منه إلى جميع تلك المقدّمات مع قيد الموصليّة آلاف من الوجوبات الغيرية، وحيث إنّ هذا القيد لا يحصل إلّا في ظرف إتيان المكلّف بذي المقدّمة يلزم أن يتعلّق من هذه المقدّمات بعدد
ص: 192
جميعها وجوب غيريّ مقدّميّ بذي المقدّمة، فيصير ذو المقدّمة مقدّمة لما تكون مقدّمة له ومتوقّفاً على ما يكون متوقّفاً عليه، وهذا دور محال.
لا يخفى عليك: أنّ الأقوال الثلاثة المذكورة - أي ما ذهب إليه صاحب المعالم(قدس سره) من كون وجوب المقدّمة مشروطاً بإرادة المكلّف إتيان ذيها، وما نسب إلى الشيخ(رحمه الله) من إطلاق الوجوب وتقييد متعلّقه وكون الواجب ما اُريد به التوصّل إلى ذي المقدّمة، وما اختاره صاحب الفصول(رحمه الله) من كون المقدّمة المقيّدة بالإيصال متعلّقاً للوجوب - إنّما ظهرت لتصحيح العبادة الّتي يتوقّف على تركها فعل الواجب الفوري، كالصلاة الّتي تتوقف على تركها الإزالة. وسيجيء إن شاء الله تعالى التعرّض لذلك على النحو المستوفى في مبحث الضدّ.
ثمرة النزاع((1))
لا يخفى عدم ترتّب ثمرة على البحث في وجوب المقدّمة؛ فإنّه ولو قلنا بوجوب المقدّمة إلّا أنّ وجوبها ليس إلّا وجوباً تطفّليّاً مندكّاً في وجوب ذي المقدّمة بحيث لا يمكن بالنسبة إليه تصوّر الامتثال والعصيان، كما سيتّضح لك إن شاء الله تعالى.
إعلم: أنّه ليس في المسألة أصل يعوّل عليه عند الشكّ؛ فإنّه ليس لوجوب المقدّمة أثر شرعي حتى يستصحب أو تجري فيه البراءة.
ص: 193
وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني(قدس سره) من صحّة استصحاب عدم وجوبها؛ لأنّ نفس وجوب المقدّمة يكون مسبوقاً بالعدم حيث يكون حادثاً بحدوث ذيها، فالأصل عدم وجوبها.((1))
ففيه: أنّه إن أراد من استصحاب عدم وجوبها نفي استحقاق المكلّف للعذاب على تركها، فنفي استحقاق العقاب وإثباته ليس من الاُمور التعبّدية حتى يتعبّدنا به. مضافاً إلى أنّ ترك المقدّمة غير موجب لذلك كما أنّ فعلها أيضاً ليس سبباً لاستحقاق الثواب، بل استحقاق الثواب والعقاب راجع إلى امتثال الأمر النفسي وعصيانه.
وإن أراد بذلك نفي فعليّة وجوب المقدّمة، فلا يتمّ أيضاً ما أفاده؛ لأنّه بعد الالتزام بأنّ وجوب المقدّمة - على القول به - لا يكون إلّا ظلّا لوجوب ذيها، كيف يمكن نفي فعلية وجوبها مع بقاء فعلية وجوب ذي المقدّمة؟
وبالجملة: فلا فائدة لإجراء الاستصحاب؛ لأنّه لو تعلّق الوجوب بالمقدّمة واقعاً فلا يمكن نفي فعليته بسبب الاستصحاب بعد فرض بقاء فعليّة ذي المقدّمة، وإن لم يتعلّق الوجوب فلا فائدة لذلك.
هذا، مضافاً إلى أنّ نفي فعليّة وجوبها بالاستصحاب لا فائدة له أصلاً؛ لأنّ على المكلّف الإتيان بالمقدّمة على کلّ حال من جهة توقّف الواجب عليها قلنا بوجوبها الغيري أم لا.
بعد ما عرفت المقدّمات، ندخل في أصل البحث، وقبل ذلك نحرّر محل النزاع بأنّه هل يتوجّه من قِبل الأمر بالواجب أمر إلى کلّ مقدّمة من مقدّماته؟ بمعنى أنّ العقل
ص: 194
يحكم بأنّ لازم ذلك تولّد أمر واحد من الأمر بالواجب لو كانت المقدّمة واحدة، أو أكثر إذا كانت المقدّمات أكثر - ولو كان الآمر غافلاً - أم لا؟
ولا وجه لتوهّم كون النزاع في الوجوب العقلي وأنّ العقل هل يحكم بوجوب إتيان المقدّمة أو لا؟ لأنّ هذا غير قابل للنزاع، لرجوعه إلى اللابدّيّة العقلية ولزوم إتيان المقدّمة بحكم العقل حفظاً من الوقوع في مفسدة ترك ذي المقدّمة. فليس محلّ النزاع ومرجع الاختلاف إلّا الوجوب الشرعي((1)) بالمعنى الّذي ذكرناه.
ص: 196
ولا يخفى عليك: أنّ مراد المفصّل (بين السبب وغيره) من السبب: الفعل المباشريّ الّذي هو تحريك العضلات كتحريك اليد، ومن المسبّب: الفعل الّذي يوجد بعين تحريك العضلات من غير توسط إرادة اُخرى بينه وبين الفعل كحركة المفتاح المسبّب من تحريك اليد وكذا انفتاح الباب، فالفعل الحاصل من السبب من غير توسط إرادة بينه وبين حصول ذلك الفعل هو المسبّب كتحريك المفتاح وانفتاح الباب. إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الوجه الّذي توهّم للقول بالتفصيل هو عدم قدرة المكلف على المسبّب في الأفعال التوليدية وأنّ الأمر فيها يتعلّق بالسبب.
وقد ظهر فساد هذا التوهّم ممّا ذكرناه سابقاً عند البحث في أنّ الأوامر المتعلّقة بالمسبّبات ظاهراً هل هي متعلّقة بها حقيقة أو لا؟ وقلنا بإمكان تعلّقها بالمسبّبات أيضاً حقيقةً، لأنّ المقدور بالواسطة مقدور. مضافاً إلى أنّه ولو كان لکلّ من تحريك اليد وتحريك المفتاح وانفتاح الباب وجوداً مستقلّا وإيجاداً كذلك لاتّحاد الوجود والإيجاد من جهة أنّ الفرق بينهما ليس إلّا أنّ ما وجد إذا نسب إلى الفاعل نسمّيه بالإيجاد وبالنسبة إلى نفسه يسمّى بالوجود، ولكن من جهة ملاحظة حصول هذه الثلاثة من فاعل واحد وعدم توسيط إرادة اُخرى بين تحريك اليد وحركة المفتاح وانفتاح الباب تعدّ فعلاً واحداً، فلا مانع من تعلّق الأمر بالمسبّب أيضاً.
هذا، مضافاً إلى أنّ التفصيل خارج عمّا هو محلّ النزاع في مبحث المقدّمة، وإنّما هو نزاع آخر في متعلّق الأمر النفسي، وأنّه السبب أو المسبّب؟ فيكون أجنبيّاً عمّا نحن فيه.((1))
وأمّا وجه توهّم التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره، فهو ما يتراءى من وقوع
ص: 197
بعض الواجبات في الخارج كالصلاة والصوم وغيرهما من غير تحقّق شرائطها، فلو لم نقل بوجوب الشرط يلزم حصول الموافقة بمجرّد حصول الواجب، ومن الواضح بطلانه، فهذا دليل تقيّد الواجب بشرطه كالطهارة مثلاً، فالصلاة المقيّدة بها على نحو يكون القيد خارجاً والتقيد داخلاً تكون متعلّقة للوجوب. وبعبارة اُخرى: إنّ متعلّق الوجوب هو الصلاة الواقعة بعد الغسلتين والمسحتين، وحيث لا يمكن تعلّق الوجوب بالتقيّد فلابدّ من تعلّقه بالقيد الّذي يكون منشأً لانتزاع التقيّد.
وفيه: أنّ الأمر المتعلّق بالقيد الّذي يكون منشأً لانتزاع التقيّد هو عين الأمر بالتقيّد؛ لأنّ الأمر المتعلّق بالتقيّد راجع في الحقيقة إلى منشأ انتزاعه والوجوب المتعلّق به وجوب نفسيّ.
هذا، مضافاً إلى إمكان إنكار وقوع ذي المقدّمة بدون شرطه الشرعي، ودعوى رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي، فالصلاة لا تقع في الخارج إلّا بعد حصول مقدّمتها وهي الطهارة، وإن كان بحسب الظاهر يتخيّل وقوعها بدون مقدّمتها؛ لأنّه ربما كان المأمور به عنواناً ينطبق على أفعال خاصّة مشروطة بوجود اُمور معها بحيث لا ينطبق ذلك العنوان إلّا بعد حصول تلك الشروط، مثل عنوان الصلاتية؛ فإنّه لا ينطبق على القيام والركوع والسجود وغيرهما إلّا بعد حصول المسحتين والغسلتين، فتحقّق هذا العنوان في الخارج لا يمكن إلّا بهذا الشرط. والعقل وإن لم يدرك توقّف حصول هذا المأمور به وانطباق عنوانه على هذه الأفعال مقيّدة بهذا القيد، ولكنّ الشرع كشف عن ذلك بخطاب إرشاديّ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ...﴾ الآية.((1))
ص: 198
أمّا الوجوه الّتي ذكروها لإثبات الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة والمقدّمة، وأنّه يتولّد من الطلب النفسيّ طلب غيريّ متعلّق بالمقدّمة، وأنّ الأمر كما يبعث المكلّف نحو ذي المقدّمة يبعثه نحو المقدّمة، فهي كثيرة ربما تتجاوز عشرين دليلاً، ذكر أكثرها المحقّق السبزواري.((1))
منها: الدليل المشهور بينهم عن أبي الحسين البصري،((2)) وهو قياس اقتراني شرطي.
بيانه: لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها، وحينئذٍ فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً؛ ينتج أنّه لو لم تجب المقدّمة يلزم إمّا التكليف بما لايطاق، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً، واللازمان باطلان فالملزوم مثلهما.((3))
ولا يخفى بطلان هذا الدليل، فإنّه إن أراد ممّا هو الأوسط في القياس وهو قوله: «وحينئذٍ» جواز ترك المقدّمة الّذي هو التالي في الشرطية الاُولى، فالملازمة بينه وبين التالي في الشرطية الثانية ممنوعة؛ لأنّه لا يلزم من بقاء ذي المقدّمة على وجوبه التكليف
ص: 199
بما لا يطاق. وإن أراد منه ترك المقدّمة أي فحين ترك المقدّمة إمّا أن يبقى الواجب... الخ، فبطلان القياس من جهة عدم تكرر الأوسط واضح.
ومنها: ما استدلّ به المحقّق الخراساني(رحمه الله) من إرجاعه وجوب المقدّمة إلى الوجدان؛((1)) فإنّه شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئاً له مقدّمات أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها. ولذلك يصحّ من المولى أن يقول: ادخل السوق واشتر اللحم، فيجعل المقدّمة في قالب الطلب، ومن الواضح أنّ ملاك الأمر بدخول السوق ليس إلّا مقدّميته لشراء اللحم. فكما أنّ دخول السوق يكون متعلّقاً لطلبه وإرادته لكونه مقدّمة لشراء اللحم، فليكن كذلك حال کلّ مقدّمة من مقدّمات الواجب من غير فرق بينها، فكلّها متعلّقة لطلبه، لوجود هذا الملاك في الجميع.((2))
وفيه: أنّ البعث إلى دخول السوق بعث إلى شراء اللحم حقيقة، ولا يكون للدخول صفة المطلوبية أصلاً. فلو سئل المولى عن عدد مطلوباته في ما إذا بعث عبده نحو فعل تكون له مقدّمات كثيرة؟ لأجاب عن وحدة مطلوبه وأنّ المبعوث إليه ليس إلّا الفعل المذكور ومطلوبه النفسي.
ومنها: استدلال بعض المعاصرين((3)) بأنّه كما تتولّد من الإرادة التكوينية المتعلّقة بفعل إرادات اُخر متعلّقة بمقدّماته، كذلك تتولّد من الإرادة التشريعية - وهي إرادة صدور الفعل من العبد باختياره - إرادات متعلّقة بصدور مقدّمات هذا الفعل منه.
وفيه: أنّه فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية؛ فإنّه لا يعقل صدور الفعل في الاُولى إلّا بذلك، وأمّا في الثانية فيمكن أن يريد المولى ذلك الفعل من دون توجّه إلى
ص: 200
مقدّماته، وينشأ الطلب لأجل حدوث إرادة الفعل في العبد، ثم إذا أراد العبد إتيان الفعل تتولد من إرادته هذه إرادات اُخر متعلّقة بمقدمات الفعل.
ثم إنّه قد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ القول بعدم وجوب المقدّمة ليس ببعيد عن الصواب.
نعم، لو اُريد من الوجوب حكومة العقل بلزوم إتيان المقدّمة لمكان توقّف ذيها عليها، فهو مسلّم، لكن أين هو من وجوبها الشرعي! ومع ذلك كله، لا مضايقة من موافقة القائل بالوجوب لو أراد منه وجوباً ترشّحياً طريقيّاً تطفّليّاً بحيث لا يكون له امتثال ولا عصيان ولا أثر آخر، بل كان واجباً بوجوب ذي المقدّمة بالعرض.
والحاصل: إنّ المقدّمة باعتبار عدم ترتّب أثر على وجوبها، غير واجبة. وباعتبار أنّ الطلب المتعلّق بالشيء يستتبع الطلب المتعلّق بمقدّماته بالعرض، واجبة.
وأمّا لو أراد من وجوبها كون الوجوب المتعلّق بها وجوباً وطلباً وبعثاً في مقابل الطلب والبعث المتعلّق بالواجب النفسي، بحيث لو سألنا المولى عن عدد مطلوباته يعدّ کلّ واحدة من المقدّمات مطلوباً على حدة، فهو ممنوع جدّاً.
ويمكن أن يكون نظر صاحب الفصول(رحمه الله) - في اختياره تعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة الموصلة - إلى ما أشرنا من عدم تشخّص وتعيّن ونفسية وجوب المقدّمة إلّا بحسب الوجوب المتعلّق بذيها، فحيث إنّه رأى أنّ القول بالوجوب مطلقاً (موصلة كانت المقدّمة أم غير موصلة) مستلزم لعدم صحّة القول بمعصية العبد إذا أتى بالمقدّمة المحرّمة الّتي لم يترتّب عليها ذو المقدّمة مع أنّ هذا فاسد؛ ذهب إلى وجوب المقدّمة الموصلة، بمعنى أنّ وجوب المقدّمة حيث لا يكون له وجود واقعاً وإنّما يطلق
ص: 201
عليها الواجب مسامحة، فلو صادف مع وجودها وجود الواجب وترتّب الواجب عليها لا تقع المقدّمة المحرّمة على صفة الحرمة لوقوعها مقدّمة للواجب الأهمّ، وأمّا لو لم يترتّب عليها الواجب فحرمتها باقية على حالها؛ لأنّ الطلب المتعلّق بالمقدّمة ليس طلباً له واقعاً، فتأمّل.
مقدّمة المستحبّ والحرام((1))
قد ظهر ممّا ذكر حال مقدّمة المستحب، فكلّ ما قيل أو يقال في مقدّمة الواجب يقال فيها.
وأمّا مقدّمة الحرام، فلو قلنا بأنّ النهي عبارة عن الزجر عن الفعل فلا يعقل تولّد زجر آخر من الزجر الراجع إلى ذيها يكون راجعاً إلى المقدّمة. ولو قلنا بأنّ النهي عبارة عن طلب الترك، وقلنا بثبوت الوجوب الغيري في مقدّمة الواجب فلا مناص من القول بحرمة مقدّمات الحرام حرمة غيرية في الجملة؛ لأنّ الملاك في كلتيهما واحد، إلّا أنّ مقدّمات الحرام حيث لا يتوقّف الترك فيها على ترك جميع المقدّمات فالحرمة تتعلّق بفعل المقدّمة السببیّة بل بالجزء الأخير من العلّة التامّة للفعل، فلا يحرم من المقدّمات إلّا ما يؤدّي إلى المحرم، فتدبّر جيّداً.
ص: 202
ص: 203
هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟
وقبل الخوض في المطلب ينبغي تقديم اُمور:
إنّ الضدّ على اصطلاح أهل المعقول: کلّ أمر وجوديّ يمكن تعقلّه من غير تعقّل مقابله. وذلك لأنّ کلّ أمر إذا لوحظ مع أمر آخر فإمّا أن يكونا متخالفين، أو متماثلين، أو متقابلين. والمتقابلان إمّا أن يكون أحدهما الوجود والآخر العدم الّذي ليس من شأنه الوجود، أو العدم الّذي من شأنه الوجود. وإمّا أن يكون کلّ منهما أمراً وجودياً لم يمكن تعقّل أحدهما بدون الآخر، أو يمكن ذلك. فالمتناقضان: ما يكون أحدهما الوجود والآخر العدم الّذي ليس من شأنه الوجود. والعدم والملكة: ما يكون أحدهما الوجود والآخر العدم الّذي من شأنه الوجود. والمتلازمان: (وقد يعبر عنهما بالمتضائفين) ما لا يمكن تعقّل أحدهما بدون الآخر. والمتضادّان: ما يمكن تعقّل أحدهما بدون الآخر.
وأمّا في اصطلاح الاُصوليين فيطلق الضدّ تارة: على الضدّ العامّ بمعنى الترك أو
ص: 204
أحد الأضداد الوجودية لا بعينه. واُخرى: على کلّ أمر وجوديّ لا يمكن اجتماعه مع أمر وجوديّ آخر، ويسمّونه بالضدّ الخاصّ.
ومن هنا يظهر أنّ الضدّ في اصطلاح الاُصوليين أعمّ من الضدّ المصطلح عليه عند أهل المعقول؛ لأنّه عند الاُصوليين يشمل کلّ ما يمكن تعقلّه بدون تعقّل مقابله، وما لم يمكن تعقّله كذلك فيشمل المتضائفين أيضاً.
إنّ المتقدّمين قد جعلوا النزاع في الضدّ من مبادئ علم الاُصول، وذكروه في المبادئ الأحكامية الّتي تكون قسماً من المبادئ التصديقية لعلم الاُصول؛ فإنّ مبادئه التصديقية على أقسام: أحدها: ما يوجب ذكره بصيرة في مسائل العلم، مثل ذكر معنى الوجوب والحرمة، وسمّوه بالمبادئ اللغوية. وثانيها: ما يبحث فيه عن الحسن والقبح والإدراكات العقلية، وسمّوه بالمبادئ العقلية. وثالثها: ما يبحث فيه عن حالات الأحكام وكيفياتها وملازماتها والنسب الواقعة بينها واجتماع بعضها مع بعض وتقسيمات الأحكام، مثل تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي، وتقسيم التكليفي إلى الأحكام الخمسة التكليفية، وسمّوه بالمبادئ الأحكامية.
وكيف كان، فبحثنا هذا إنّما يكون من المبادئ الأحكامية، ولا ينبغي أن يعدّ من المسائل الاُصولية.
قد وقع اختلاف في المقام بين الاُصوليين، فذهب بعضهم إلى أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، ولم يذكر ما أراد من الضدّ. وبعضهم قال باقتضائه النهي
ص: 205
عن ضدّه العامّ، وعنى الترك من الضدّ العامّ. وبعضهم عنى منه أحد الأضداد الوجودية لا بعينه. وذهب بعضهم إلى أنّه يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ، ثم اختلفوا في كيفية الاقتضاء. فبعضهم قال بأنّ الأمر عين النهي عن الضدّ. واختار آخرون جزئية النهي عن الضدّ للأمر. ومذهب بعضهم أنّ النهي عن الضدّ يكون لازماً للأمر. واختلف القائلون بالمذهب الأخير، فقال بعضهم بأنّ النهي عن الضدّ يكون لازماً بيّناً بالمعنى الأخصّ للأمر. وذهب بعض منهم إلى أنّه لازم له بالمعنى الأعمّ.
إذا عرفت هذه الاُمور، فاعلم: أنّ المسألة عقلية، ولا أثر لاختلاف آرائهم فيما هو المهمّ.
ينبغي تقديم البحث عن الضدّ العامّ الّذي اُريد منه الترك. والظاهر أنّ هذا مراد القائل بأنّ الأمر عين النهي عن ضدّه، وإلّا فمن الواضح فساد دعوى العينية لو اُريد من الضدّ، الضدّ العامّ بمعناه الآخر، أو الضدّ الخاصّ. كما أنّه لا يبعد أن يكون هذا المعنى مراد من قال بأنّه جزؤه.
ولا يخفى: أنّ منشأ القول بجزئيّة النهي عن الضدّ للأمر: تعريفهم للوجوب بأنّه طلب الفعل مع المنع من الترك، فتوهّموا أنّ المنع من الترك يكون جزءً لمعنى الوجوب. والحال أنّ المراد بذلك بيان درجة تأكّد الطلب لا أنّ معنى الوجوب مركّب من هذا وذاك؛ لأنّ الطلب حيث يكون مقولاً بالتشكيك يكون له مراتب ودرجات فأقواها ما نسمّيه بالوجوب.
وأمّا منشأ القول بأنّ النهي عن الضدّ عين معنى الأمر فهو: ما ذكر في النواهي من
ص: 206
أنّ النهي طلب الترك، حيث إنّ متعلّق الترك تارة يكون الفعل، واُخرى يكون الترك، بحسب اختلاف المقامات، ففيما نحن فيه طلب الترك متعلّق بترك الواجب، فمعنى النهي عن الضدّ طلب ترك ترك الواجب وهو عين الأمر به.
وبعبارة اُخرى: منشأ القول بالعينية: ما ذكروه في باب النواهي من أنّ النهي طلب الترك، وحيث إنّ متعلّق الترك يكون ضدّ الواجب فالطلب يكون متعلّقاً بترك الترك لا محالة، وهذا لا يتحقّق إلّا بفعل الواجب وحصوله، فالأمر بالشيء الّذي هو عبارة عن طلب الفعل يكون عين النهي عن ضدّه الّذي معناه طلب ترك ترك ذلك الفعل، فالأمر الّذي هو عبارة عن طلب الفعل مغاير للنهي عن ضدّه مفهوماً ومتّحد معه مصداقاً، ويحمل هذا عليه بالحمل الشائع الصناعي.
كما أنّ النهي على ذلك يكون عين الأمر بالفعل. وليس معنى ذلك أنّ النهي حكم والأمر حكم آخر بمعنى توجّه الحكمين والتكليفين إلى المكلّف، بل المراد أنّ معنى الأمر بالشيء وطلب وجود فعل يكون طلب ترك تركه، ففي نفس الأمر يتحقّق ذلك الترك والوجود بإيجاد الفعل.
لا يقال: كيف يمكن أن يكون الفعل الواحد مصداقاً للوجود والعدم؟ فلا محيص عن القول بالملازمة بين الحكمين.
لأنّه يقال: إنّ المراد بالضدّ في المقام ليس النقيض المصطلح - الّذي ربما يقال في تعريفه: نقيض کلّ شيء رفعه - حتى يصير طلب ترك الترك أمراً عدمياً، بل المراد منه ما كان في مقابل شيء سواء كان من الاُمور العدمية كالترك بالنسبة إلى الفعل، أو الوجودية كالفعل بالنسبة إلى الترك. فعلى هذا، نقول: إنّ معنى النهي عن الضدّ هو طلب ترك النقيض، وفي نفس الأمر ترك النقيض لا يتحقّق إلّا بفعل الواجب.
هذا، وقد ظهر ممّا حقّقناه أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام بمعنى
ص: 207
الترك بناءً على كون معنى النهي طلب الترك. وكذلك لو كان الأمر بمعنى البعث، والنهي بمعنى الزجر على ما قوّيناه، فالأمر الّذي هو عبارة عن بعث المكلّف نحو الفعل وجلبه إليه عين الزجر عن ضدّه العامّ خارجاً ومصداقاً، كما أنّ الزجر عن الضدّ عين البعث إلى الفعل مصداقاً وإن كانا متغايرين مفهوماً. هذا تمام الكلام في الضدّ العامّ بمعنى الترك.
يعرّف الضدّ الخاصّ بأنّه: کلّ أمر وجودي لا يمكن اجتماع صدوره مع الواجب من المكلّف الواحد في زمان واحد، كالصلاة مع إزالة النجاسة عن المسجد، أو هي مع أداء الدين. ولا يخفى: أنّ هذا هو المهمّ في المقام ومحلّ النزاع بين الأعلام.
وقد استدلّ على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ بوجهين:((1))
الأوّل: أنّ فعل الضدّ، كالصلاة مثلاً، مستلزم لترك الإزالة الواجبة، وترك الإزالة حرام؛ لأنّه الضدّ العامّ الّذي يكون الأمر بها عين النهي عنه، ففعل الضدّ مستلزم للحرام وما يستلزم الحرام حرام.
الوجه الثاني: أنّ أداء الدين فوراً أو الإزالة واجب يتوقّف على ترك الصلاة وما يتوقّف عليه الواجب واجب، فترك الصلاة واجب وترك تركها حرام.
ولا يخفى: أنّ الدليل الأوّل اُخذ من حرمة الضدّ العامّ بمعنى الترك، بتقريب: أنّ فعل الضدّ مستلزم لترك الإزالة المحرّم من جهة كون هذا الترك ضدّ عامّ لفعل الإزالة الواجبة، ومستلزم المحرّم محرّم ففعل الضدّ محرم.
والدليل الثاني اُخذ من وجوب إتيان الواجب، بتقريب: أنّ أداء الدين المأمور به
ص: 208
واجب وهو يتوقّف على ترك الصلاة وما يتوقّف عليه الواجب واجب فترك الصلاة واجب. وحيث إنّ فعل الضدّ العامّ محرّم فترك ترك الصلاة الّذي هو عبارة اُخرى عن فعلها حرام.
ولا يخفى أيضاً: أنّ تمامية الدليل الأوّل تتوقّف على حرمة مقدّمة الحرام؛ لأنّ معنى استلزام فعل الضدّ لترك الواجب سببية فعله ومقدّميته لتركه. وتمامية الدليل الثاني تتوقّف على وجوب المقدّمة. كما أنّ دليلية الدليلين موقوفة على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه العامّ.
هذا، والّذي ينبغي أن يقال: إنّ المضادّة بين شيئين كالسواد والبياض وغيرهما من نظائرهما إنّما تكون من الإضافات المتشاكلة الأطراف كما في الاُخوّة، فما فرض في أحدهما لابدّ وأن يفرض في الجانب الآخر؛ لأنّهما متشابهان على المفروض، وبناءً عليه لو فرض استلزام وجود أحد الضدّين لعدم الضدّ الآخر كما هو المبيّن في الوجه الأوّل، فلابدّ من القول بكون وجود الآخر أيضاً مستلزماً لعدم ضدّه.
وهكذا لو قلنا بأنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لوجود الآخر كما هو المذكور في الوجه الثاني، فلابدّ وأن يكون ترك الآخر مقدّمة لوجود ضده، فيلزم من ذلك أن تكون مرتبة کلّ واحد من الضدّين متأخّرة عن الآخر ومتقدّمة عليه، بل يلزم تأخّره عن نفسه وتقدّمه على نفسه.
ووجهه: أنّه إذا كان ترك الضدّ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر يلزم أن يكون وجوده أيضاً متقدماً على وجود هذا الشيء بحسب الرتبة لاتّحاد مرتبة الوجود والعدم، فوجود هذا الضدّ كما يكون متأخّراً عن عدم الضدّ الآخر يكون متأخّراً عن وجوده أيضاً، وهذا المتأخّر يجب أن يكون متأخّراً عن المتقدّم وعن کلّ ما تأخّر عنه المتقدّم؛ لأنّ المتأخّر عن المتأخّر عن الشيء متأخّر عن ذلك الشيء، ومن جملة
ص: 209
ما تأخّر عنه المتقدّم وجود هذا الضدّ المتأخّر؛ لأنّ وجود المتقدّم أيضاً موقوف على عدم المتأخّر، فتكون مرتبة وجود المتأخّر متقدّمة على المتقدّم، فيلزم تأخّر المتأخّر عن نفسه.
وأيضاً إذا كان ترك الضدّ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر يكون وجوده أيضاً متقدّماً عليه - بحسب المرتبة - وعلى کلّ ما يكون متأخّراً عنه، ومن جملة ما يكون متأخّراً عنه هذا الضدّ المتقدّم؛ لأنّ عدم هذا الضدّ المتأخّر يكون مقدّمة لوجوده، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه، وهذا محال.
إنّ المستفاد من كلمات السابقين التزامهم بالمقدّمية، كما هو الظاهر من جواب العضدي والحاجبي عن الدليل الثاني؛ فإنّهما التزما في الجواب بنفي وجوب المقدّمة مع اعترافهما بأصل المقدّمية.((1))
ويستفاد هذا أيضاً منهم في ردّهم شبهة الكعبي،((2)) حيث قال: إنّ كل فعل إمّا يكون مقدّمة للواجب فيجب، أو مقدّمة لترك الحرام فيجب أيضاً، لأنّ ترك الحرام واجب.
وأجابوا عنها: بأنّا لا نسلّم وجوب مقدّمة الواجب.((3)) ولكنّه قد ظهر ممّا حققناه عدم إمكان القول بالمقدّمية، وأنّ كلماتهم في المقام خالية عن التحقيق.
ص: 210
إنّ مقتضى التحقيق أن يقال في مقام الجواب: إنّ ما هو تمام الملاك للقول بالاقتضاء هو مقدّمية الترك لوجود الضدّ بملاحظة استحالة اجتماع وجود الضدّين كالسواد والبياض في محلّ واحد وفي زمان واحد. فالتضادّ الواقع بينهما موجب لامتناع اجتماع وجودهما كذلك وعلى نحو المعيّة، فوجود الضدّ في حال معيّته مع الضدّ الآخر محال. فلو فرضنا معيّة أحدهما مع عدم الآخر ارتفعت تلك الاستحالة وانقلبت مادّة الامتناع إلى الإمكان.
فكما أنّ ملاك الامتناع والاستحالة هو ضدّية وجود کلّ منهما مع الآخر ومعيّة وجود کلّ منهما لوجود الآخر، فليكن رفع هذا الامتناع بملاك معية وجود کلّ منهما لعدم الآخر.
وكما أنّ الضدّية - الّتي هي تمام الملاك للامتناع - ليست إلّا بأن يكون الضدّان في مرتبة واحدة من الوجود وعلى نحو المعيّة ولا يكون لأحدهما تقدّم على الآخر بنحو من أنحاء التقدّم، كذلك لابدّ وأن يكون نقيض کلّ من الضدّين مع نقيض الآخر في رتبة واحدة وعلى نحو المعيّة، فعلى هذا يكون نقيض أحد الضدّين في مرتبة الضدّ الآخر.
فبناءً عليه كما أنّ ملاك حكم العقل بالامتناع في الوجود لا يكون إلّا لفرض كونهما في مرتبة واحدة، كذلك حكم العقل بإمكان وجود أحدهما مع عدم الآخر لا يكون إلّا لفرض أنّ الوجود والعدم في مرتبة واحدة، فعلى هذا لا يمكن أن يكون عدم أحد الضدّين مقدّمة لوجود الآخر وبالعكس، كما لا يخفى.
ثم إنّه ربما يقال بأنّ عدم الضدّ عند وجود الضدّ الآخر يكون من باب عدم المانع
ص: 211
عند وجود المعلول، وحيث لا إشكال في كون عدم المانع من المقدّمات وأجزاء العلّة فليكن عدم الضدّ أيضاً بالنسبة إلى وجود الضدّ الآخر كذلك.((1))
ولكن يمكن أن يقال: بأنّ أجزاء العلّة - من المقتضي والشرط وعدم المانع - ليست كلّها في مرتبة واحدة وفي عرض واحد، بل يستند عدم المعلول إلى کلّ واحد منها على نحو الطولية، فيستند عدم المعلول أوّلاً إلى عدم المقتضي لو فرض عدمه؛ ولو فرض وجوده فيستند إلى عدم الشرط؛ ولو فرض وجوده أيضاً فيستند إلى وجود المانع. فالمانع يؤثّر ويمنع المقتضي من التأثير بعد حصول الشرط، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ لأنّ عدم الضدّ غير مستند إلى وجود المانع حتى يقال بأنّ عدمه من المقدّمات، بل هو مستند إلى عدم مقتضيه.
إنّ هذا الإشكال إنّما يتمّ في مقام التأثير الفعلي، وأمّا بحسب مقام الشأنية والصلاحية فالمانع ما يصلح للمانعية ولو كان قبل وجود المقتضي، فإنّ معنى المقدّمية لا يجب أن يكون فعلياً، فبناءً على هذا لو فرضنا صلاحية وجود الضدّ للمانعية عن الضدّ الآخر لابدّ لنا من القول بكون عدمه مقدّمة لوجود الآخر.
قد يقال في ثمرة النزاع بأنّ القول بالاقتضاء، وأنّ النهي في العبادات موجب للفساد، ينتج فساد الضدّ إذا كان عبادياً.
ص: 212
واستشكل الشيخ البهائي(رحمه الله)((1)) على ترتّب هذه الثمرة بأنّا ولو قلنا بأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه لكن مع ذلك لا إشكال في أنّ مقتضى الأمر بالشيء عدم الأمر بضدّه، فالأمر بإزالة النجاسة أو أداء الدين وإن لم يقتض النهي عن الصلاة إلّا أنّه يقتضي عدم الأمر بها وإلّا يلزم الأمر بالضدّين وهو محال، لا من جهة قبح صدوره عن الآمر الحكيم، بل ولا من جهة أنّه تكليف بالمحال، بل لأنّه محال بنفسه؛ لأنّ معناه إيجاب ما هو المحال، والإيجاب متفرّع على انقداح الإرادة النفسانية ومع فرض الاستحالة لا يمكن انقداح تلك الإرادة من الحكيم وغيره، فبناءً عليه يقتضي الأمر بالشيء عدم الأمر بضدّه، فالأمر بالإزالة يقتضي عدم الأمر بالصلاة المضادّة لها، وهذا يقتضي بطلان الصلاة لو ترك الإزالة وأتى بها؛ لأنّها ليست مأمورا بها فلا يمكنه قصد الأمر الّذي تتوقّف عليه صحّة العبادة.
وأجابوا عنه أوّلاً: بأنّا لا نسلّم استحالة الأمر بالضدّين مطلقاً؛ لأنّا لا نرى في ذلك مانعاً واستحالة إذا كان أحد الضدّين موسّعاً والآخر مضيّقاً.((2))
وثانياً: سلّمنا أنّ الأمر بأحد الضدّين موجب لعدم الأمر بالآخر وأنّه لا يمكن في مقام الامتثال قصد أمره، إلّا أنّ هذا لا يرفع المصلحة الكائنة في فعل الضدّ الآخر، ويكفي في تحقّق الامتثال قصد تلك المصلحة والمطلوبية الذاتية.((3))
ص: 213
وثالثاً: بأنّ الأمر بالضدّين لو فرض استحالته فهو إنّما يكون موجباً للمحال لو كان الأمر بهما في محلّ واحد وآن واحد على الإطلاق، لكن إذا كان أحدهما - الّذي يكون أهمّ من الآخر - على نحو الإطلاق والآخر مشروطاً بعصيان الأهمّ على سبيل الترتّب، فلا يوجب المحال. وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.((1))
بأنّ معنى الموسعية لو كان هو الكلّية بحسب الزمان بمعنى أنّ الآمر لاحظ المأمور به في امتداد من الزمان وكان لهذا الامتداد أجزاء بحيث تكون نسبة الامتداد إلى أجزائه كنسبة الكلّ إلى أجزائه لا كنسبة الكلّي إلى أفراده وجزئياته، فعلى هذا يكون الأمر الواحد متعلّقاً بشيء واحد في مجموع هذه الأجزاء الزمانية، فيكون لحاظ المأمور به في هذا الامتداد لحاظه في أجزائه إذ الكلّ هو عين الأجزاء بالأسر، فلا يمكن انفكاك لحاظ الكلّ عن لحاظ الأجزاء، والمفروض وجود أمر آخر، كالإزالة مثلاً، من المولى في بعض هذه الأجزاء الزمانية، وليس هذا غير الأمرين بالضدّين.
وكذا لو كان معنى الموسعية التخيير الشرعي، بمعنى أنّ کلّ فرد من الأفراد الموجودة في هذا الظرف يكون متعلّقاً لأمر خاصّ، فكلّ فرد منها بما أنّه واقع في جزء من هذا الظرف الزماني واجد لهذه الخصوصية، فله أمر خاصّ به، فيكون تمام الأفراد بخصوصياتها مورداً لأمر مستقلّ لكن على سبيل التخيير، فعليه لا يصحّ الأمر بالفرد المزاحم مع ما يضادّه وهو مأمور به أيضا؛ لأنّ هذا عين الأمرين بالضدّين، هذا.
ص: 214
إنّ التحقيق((1)) في معنى الموسعية أنّه ليس أحد الوجهين المذكورين، بل معناه أنّ المأمور به يكون طبيعة الفعل على وجه كلّيّ بحيث تكون لها بحسب أجزاء الزمان أفراد كثيرة خارجية، وهذه الطبيعة قابلة للانطباق على جميع تلك الأفراد انطباقاً قهرياً، كما يكون في انطباق کلّ طبيعي على جميع أفراده، فعلى هذا لا يكون لتلك الأفراد - الّتي لها خصوصيات فردية مشخّصة - دخل فيما هو الملاك والمناط في الأمر بالطبيعة؛ لأنّ المصلحة إنّما تترتّب على صرف الطبيعة المأمور بها، أمّا الخصوصيات الفردية فهي خارجة عن الملاك فلابدّ أن تكون خارجة عمّا هو متعلّق الأمر، ومن الواضح أنّ ما ليس له دخل في متعلّق الأمر ليس له دخل في تحقّق الامتثال.
وإن شئت مزيد توضيح لذلك فاعلم: أنّ الفعل الّذي يتعلّق به البعث والتحريك الإنشائي ويكون متعلّقاً للإرادة التشريعية لابدّ وأن تكون له مصلحة تترتّب عليه عند وجوده في الخارج ملازماً لوجود تلك المصلحة، ويكون الأمر بهذا الفعل بملاحظة تلك المصلحة لا محالة وإلّا لكان الأمر به جُزافاً ولغواً، وكذلك يلزم أن يكون لکلّ خصوصية من الخصوصيات ووصف من الأوصاف الّتي تؤخذ في متعلّق الأمر دخل في حصول هذه المصلحة وترتّب الغرض على الفعل حتى لا يكون أخذ هذه الخصوصية في متعلّق الأمر لغواً.
إذا عرفت ذلك يظهر لك أنّ طبيعة الصلاة مثلاً وجميع القيود المأخوذة فيها لابدّ وأن تكون لها مصلحة تترتّب عليها، وأن تكون القيود والخصوصيات المأخوذة فيها مؤثّرة ودخيلةً في ترتّب تلك المصلحة عليها، ومن تلك الخصوصيات الملحوظة فيها
ص: 215
كونها في وقت كذائي معيّن - أوّله الزوال وآخره الغروب مثلاً - فلا مناص من أن يكون لهذه الخصوصية دخل في ترتّب المصلحة عليها وإلّا لكان الأمر بالصلاة مخصّصاً بها لغواً.
وأمّا ما لا يكون له دخل في ذلك كخصوصية وقوعها في أوّل الوقت أو آخره أو وسطه فلا يكاد أخذه فيها؛ لأنّ أخذها يكون عبثاً ومن قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان، فالمتعلّق للأمر إنّما هو الطبيعة المشتركة بين أفرادها من أوّل الزوال إلى الغروب على نحو اشتراك الطبيعي بين أفراده، فعلى هذا لا مانع من تعلّق الأمر بالطبيعة بملاحظة المصلحة المترتّبة عليها في زمان ممتدّ ولو كان بعض أفراد هذه الطبيعة مزاحماً لتكليف آخر ومطارداً له، إذ الضدّية والمطاردة لا تكون من جانب متعلّق التكليف الّذي هو الطبيعة ليس إلّا، فلا تكون معاندة بينها وبين غيرها أصلاً، بل المطاردة والمضادّة إنّما تكون بين بعض أفرادها المخصّصة بخصوصية كونه في زمان خاصّ، ومن المعلوم أنّ هذه الخصوصية غير مأخوذة في متعلّق الأمر؛ لأنّ هذه الخصوصية (وقوعها في ذلك الجزء من الزمان أو جزء آخر منه) غير دخيلة في ترتّب المصلحة.
والحاصل: أنّ ما هو المضادّ للتكليف الآخر من أفراد هذه الطبيعة ليس مأموراً به وإن كان ممّا تنطبق عليه تلك الطبيعة انطباق الكلّي على أفراده، فليس بين المأمور به وغيره تزاحماً وتعانداً أصلاً. وهذه الطبيعة لا تصير باعتبار هذا الفرد خارجة عن كونها مقدورةً وإن كان هذا الفرد منها مزاحماً ومطارداً للغير، فلا يكون الأمر بالطبيعة الموسّعة والأمر بالطبيعة المضيّقة من قبيل الأمر بالضدّين. فإذا صحّ تعلّق الأمر بها كذلك يمكن امتثالها بإيجاد کلّ فرد من أفرادها حتى تنطبق عليه تلك الطبيعة ولو كان الفرد المأتيّ به هو الفرد المزاحم للتكليف الآخر.((1))
ص: 216
ثم إنّه قد انقدح ممّا ذكرناه ضعف ما أورده بعض الأعاظم على هذا الكلام وإن كان المحتمل أنّه من زلّات أقلام بعض المقرّرين. وهو: أنّ السرّ في استحالة الأمر بالضدّين ليس قبح صدوره عن الحكيم كما هو المشهور، بل عدم انقداح الإرادة النفسانية مع الالتفات والعلم بامتناع وجود الضدّين في نفس الآمر الحكيم، فحينئذٍ تكون قدرة المكلّف شرطاً لأصل التكليف، فلا تكاد أن تكون في نفس المولى إرادة لفعله بعد علمه بعدم قدرة المكلّف على ذلك. وفيما نحن فيه قد فرضنا أنّ المولى حَكم بفعل الأهمّ في بعض زمان المهمّ وحكمه هذا يسلب عنه القدرة على إتيان الفرد المهمّ في هذا الزمان، وحيث إنّ الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي فلا يمكن الأمر بالمهمّ في ظرف الأهمّ وزمان مزاحمته معه.
ولا يخفى ما في هذا الكلام من الغفلة عمّا فرضناه، فإنّ المفروض كون الطبيعة - خالية عن جميع الخصوصيات الفردية - تمام متعلّق الأمر، فلا يكون وقوعها في زمان المزاحمة مع ما هو الأهمّ إلّا كالحجر المضموم إلى جنب الإنسان.
هذا مضافاً إلى أنّ حكمه بعدم قدرة المكلّف على المهمّ في زمان مزاحمته مع الأهمّ هو عين المتنازع فيه؛ فإنّ النزاع لا يكون إلّا في أنّ التكليف بالمهمّ على نحو تعلّقه بالطبيعة المجرّدة عن الخصوصيات الفردية في ظرف التكليف بالأهم على نحو تعلّقه بخصوص الفرد محال أم لا؟
وقوله: إنّ الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي، ليس من المسلّمات.
هذا، ولكن لا يذهب عليك: أنّ ما ذكرناه من إمكان صدور الأمر بالضدين إنّما هو مختص بصورة عدم تضيّق الموسّع، وأمّا في صورة تضيّق وقته بحيث لو لم يأت بهذا الفرد لما تحقّق الإتيان بالطبيعة المأمور بها فلا محيص عن القول بأنّ الفرد الأخير يكون مأموراً به بالأمر التبعي للتحفظ على الطبيعة المأمور بها عن العصيان والفوت، فحينئذٍ
ص: 217
لو كان ذلك مزاحماً للأهم يكون الأمر به من الأمر بالضدّين. هذا كلّه فيما يكون أحدهما موسّعا دون الآخر.
وأمّا إذا كان کلّ منهما مضيّقاً وموقّتاً بالزمان الّذي تضيّق به الآخر، فلا يمكن تصوير الأمرين، بل لابدّ وأن يؤتى بالمهمّ بقصد المحبوبية الذاتية، لأنّ عبادية العبادة لا ينحصر طريق تحصيلها بقصد الأمر، بل يمكن القول بكفاية قصد محبوبيتها الذاتية، كما لا يخفى.
تصدّى بعض الأعاظم لتصوير الأمر بالضدّين على نحو الطولية وكون أحدهما مشروطاً بعصيان الآخر، فيكون الأمر بالمهمّ مشروطاً بعصيان الأهمّ.
وقد وقع الخلاف في إمكان ذلك واستحالته. وجوّزه المحقّق الثاني على ما يظهر عنه في بعض المسائل الفقهية،((1)) وشيّد أركانه الميرزا الشيرازي،((2)) ثم تلقّاه منه بالقبول تلميذه المعظّم السيّد محمد الفشاركي(قدس سره)، وحقّقه تلامذته عدا المحقّق الخراساني(قدس سره) فإنّه استحال ذلك.((3))
ومختارنا الحقّ هو الجواز. وقبل الشروع فيما هو المهمّ في المقام ينبغي المراجعة إلى الوجدان ليتّضح أنّ الضرورة العقلية هل هي قائمة على إمكان ذلك أو لا؟
والحقّ أنّ العقل لا يأبى عن قبول إمكانه، ولا يرى مانعاً لصحّة الأمر بالضدّين بحيث يكون أحدهما مترتّباً على عصيان الآخر، فلا يسمح للحكم بامتناعه. وهذا واضح بعد المراجعة إلى الوجدان وغنيّ عن البيان. فإنّ الوجدان حاكم بصحّة أمر المولى عبده بإنقاذ ولده الغريق على الإطلاق، وأمره بإنقاذ أخيه الغريق لكن لا على نحو الإطلاق بل بشرط عصيان أمره بإنقاذ ولده الغريق، وليس هذا من الممتنعات الوجدانية.
وأمّا البحث العقلي في ذلك وتحقيق المرام خارجاً عن إطار الوجدان، فيحتاج إلى بيان مقدّمة لم تذكر في كلمات الأعلام، فنقول: لا إشكال في أنّ ملاك استحالة الأمرين بالضدّين لا يكون إلّا امتناع اجتماع الضدّين في الخارج وأنّه لا يمكن انقداح الإرادة في نفس الآمر الملتفت إلى امتناع اجتماع الضدّين. وتحقّق هذا الملاك في الأمر الواحد المتعلّق بالضدّين في غاية الوضوح، إذ لا يمكن تعقّل تعلّق الإرادة الواحدة بالضدّين ولا يعقل انقداحها في نفس الآمر الملتفت فلا يعقل البعث والتحريك.
ولكن من الواضح عدم كون ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ المفروض في مسألة الترتّب هو أمران تعلّق کلّ منهما بغير ما تعلّق به الآخر، وكلّ منهما يدعو نحو متعلّقه الّذي هو ممكن في حدّ ذاته، ولا يكون التحريك بواحد منهما مع قطع النظر عن الآخر تحريكاً بالمحال، فلا يكون انقداح الإرادة محالاً، لأنّ كلّا منهما يبعث إلى متعلّقه الممكن في حدّ ذاته، فعلى هذا لا يكون الأمر بالأهمّ والأمر بالمهمّ من باب الأمر بالضدّين، أو الأمر بالمحال.
وبعبارة اُخرى: إنّ إرادة الأهمّ والبعث والتحريك نحوه مع قطع النظر عمّا يضادّه لا تكون من المحالات العقلية بل هي من الممكنات الواقعة كثيراً، وكذلك لا مانع من إرادة المهمّ بما هو هو وفي نفسه مع قطع النظر عن الأمر بالأهمّ. فليس هذا المقام، ومقام الأمر بالمحال والأمر بالضدّين من باب واحد، بل هنا أمران تعلّق کلّ منهما بشيء غير ما تعلّق به الآخر، ومن الواضح إمكان کلّ منهما في نفسه.
نعم، الأمران إذا كانا في مرتبة واحدة بحيث يكون البعث والتحريك بأحدهما في
ص: 218
رتبة البعث والتحريك بالآخر، يكون هذا مستحيلاً كالأمر بالضدين، بمعنى أنّ العقل كما يحكم باستحالة الأمر بجمع الضدّين، حاكم أيضاً باستحالة الأمرين بالضدّين إذا كانا في مرتبة واحدة، بحيث كان التحريك بأحدهما في عرض تحريك الآخر، وكان كلّ واحد من البعثين في مرتبة البعث الآخر.
ثم إنّه لا فرق فيما هو ملاك الاستحالة والامتناع بين ما إذا كان الأمران كلاهما بنحو الإطلاق - ويكون تحريك کلّ منهما في رتبة تحريك الآخر - ، أو الاشتراط بأن يكون كلاهما مشروطين بشرطٍ واحد، كما إذا قال السيّد لعبده: إذا دخلت السوق يجب عليك شراء اللحم وإذا دخلت السوق فاشتر الخبز. أو يكونا مشروطين بشرطين ولكن كان حصولهما في مرتبة واحدة، سواء كان الشرط اضطرارياً أو اختيارياً، فيكون بعث کلّ واحد منهما نحو متعلّقه في مرتبة بعث الآخر. فلا فرق في جميع هذه الموارد من جهة استلزامها ملاك الاستحالة العقلية وهو التحريك إلى شيء في مرتبة التحريك إلى شيء آخر.
وأمّا إذا كان أحدهما مطلقاً والثاني مشروطاً بعصيان الآخر، فلا يلزم منه ملاك الاستحالة؛ لأنّ ملاك حكم العقل بالامتناع والاستحالة ليس إلّا عدم إمكان التحريك نحو شيء في مرتبة تحريكٍ آخر نحو شيء آخر. وهذا الملاك غير موجود في المقام؛ إذ المفروض أنّ أحد الأمرين تعلّق بموضوعه على نحو الإطلاق والثاني على نحو اشتراطه بعصيان الآخر. فالتحريك بالمهمّ ليس في مرتبة التحريك بالأهمّ؛ لأنّه مشروط بعصيان الأهمّ، والتحريك بالأهمّ يكون متقدّماً على عصيانه المتقدّم على التحريك بالمهمّ، فإذا كان التحريكان في مرتبتين، كيف يمكن أن يتحقّق فيهما مناط الاستحالة العقليّة؟ وهو التحريك بشیء فی رتبه التحریک بالاخر.
لایقال : بناء علی ما ذکرتم یلزم ان یکون الامر بالاهم ایضا مشروطا بعدم
ص: 219
العصيان؛ لأنّه عند عصيانه لا يكون مأموراً به بل المأمور به عندئذٍ هو المهمّ والحال أنّ المفروض إطلاق الأمر بالأهم.
هذا، مضافاً إلى أنّ اشتراط الأمر بالامتثال أو العصيان أو كليهما غير معقول؛ فإنّه بشرط الامتثال مستلزم لتحصيل ما هو الحاصل، وبشرط العصيان مستلزم لاجتماع النقيضين، وبشرط الإطاعة والعصيان مستلزم لکلّا المحذورين، وما لا يمكن تقييده واشتراطه لا يصحّ إطلاقه، بمعنى أنّه إذا لا يمكن تقييده بعنوان الإطاعة والعصيان بأن يقال: أيّها المطيع أو أيّها العاصي افعل کذا وکذا أو أيّها المطيع والعاصي افعلا كذا وكذا، فلا يمكن إطلاقه بالنسبة إليهما.
مضافاً إلى ذلك كلّه: أنّ الإطاعة والعصيان ممّا يترتّب على الأمر في المرتبة المتأخّرة عنه، فلا يمكن أخذهما في متعلّق الأمر.
فإنّه يقال: إنّ الأمر بالأهمّ لا يكون مشروطاً بالإطاعة والعصيان حتى يستلزم المحذورات المذكورة، بل الأمر متعلّق بذات المكلّف العاصي أو المطيع مثل أن يخاطبه بقوله: يا أيّها الإنسان إفعل كذا، وهذا هو الّذي يعبّر عنه بالإطلاق الذاتي ولا محذور فيه.
إن قلت: إنّ المهمّ وإن لم يكن طارداً للأهمّ من جهة اشتراطه، ولكن الأهمّ يكون طارداً للمهمّ لفرض إطلاقه ولو بالإطلاق الذاتي.
قلت: مرتبة العصيان مرتبة عدم تأثير الأمر، ولو فرض وجود الأمر فلا يكون مؤثّراً في تحريك العبد، فلا مانع عقلاً من الأمر بالمهمّ في تلك المرتبة، وقد مرّ أنّ الأمر بالمهمّ متأخّر عن الأمر بالأهمّ برتبتين والأمر بالأهمّ متقدّم عليه بمرتبتين، والمتأخّر عن الشيء لا يمكن ارتقاؤه إلى المرتبة المتقدّمة لذاك الشيء، وما هو متقدّم على الشيء لا يمكن انحطاطه وتنزّله في مرتبة ذلك الشيء، فلا تحصل المطاردة بين المتخالفين رتبة.
ص: 220
ثم إنّه ربما یمکن أن يختلج في بعض الأذهان ويشتبه العصيان الرتبي بالعصيان الخارجي الّذي يقع في الخارج في وعاء الزمان، ويقال: إنّ عصيان الأهمّ الّذي هو شرط للمهمّ لا يكون إلّا بعد انقضاء زمان الأهمّ، والحال أنّ المفروض أنّ زمان الأهمّ عين زمان المهمّ، فلا يمكن وجود ما اشترط عليه الأمر بالمهمّ إلّا بعد انقضاء زمان المهمّ.((1))
والجواب: أنّ هذا الإشكال إنّما نشأ من خلط العصيان الرتبي بالخارجي، والحال أنّ العصيان الرتبي غير العصيان الخارجي، فإنّ العصيان الرتبي الّذي هو شرط للمهمّ يحصل قبل انقضاء زمان المهمّ في الوعاء المخصوص به، بخلاف العصيان الخارجي الزماني - الّذي هو ليس شرطاً للمهمّ - كما هو معلوم.
إن قلت: فعلى هذا، لا مانع من أمرين بالضدّين واشتراط أحدهما بإطاعة الآخر؛ لأنّ الإطاعة والعصيان يكون من قبيل النقيضين وفي مرتبة واحدة، فكما أنّ اشتراط أحد الأمرين بعصيان الآخر موجب للخروج عمّا هو مناط الامتناع وانقلاب مادّة الامتناع إلى الإمكان، فليكن اشتراط أحدهما بإطاعة الآخر كذلك.
قلت: إنّ الفرق بين الإطاعة والعصيان أوضح من أن يخفى؛ فإنّ حقيقة الإطاعة وقوع المأمور به في الزمان الّذي لابدّ وأن يقع فيه، وليس معنى كون الأمر بالمهمّ مشروطاً بإطاعة الأهمّ إلّا الأمر بأحد الضدّين بشرط وجود ضدّه، وليس هذا إلّا الأمر بالمحال والتحريك إلى الضدّين، وهذا يكون أسوء حالاً من الأمرين بشيئين في مرتبة واحدة يكون کلّ واحد منهما ممكناً في حدّ نفسه ممتنعاً بالقياس إلى الآخر.
هذا، مضافاً إلى أنّ هذا مستلزم للتناقض؛ فإنّ الأمر بالشيء بشرط وجود ضدّه
ص: 221
معناه الأمر بالشيء بشرط انقضاء زمانه وهذا مستلزم لعدم الأمر به، فيكون الأمر بالشيء مشروطاً بعدم الأمر به.
إن قلت: بناءً على ما ذكرتم لا محيص عن الالتزام بعقابين عند ترك الأهمّ والمهمّ، مع أنّ العقاب على تركهما ليس إلّا العقاب على أمرٍ غير مقدور للمكلّف، لأنّه لا يكون قادراً على إيجاد الأهمّ والمهمّ.((1))
قلت: أيّ مانع عقلي من ذلك بعد فرض تعلّق الأمرين بهما على سبيل الترتّب؟ فلا يكون ذلك عقاباً على غير مقدور، لأنّه قادر عليهما على نحو الترتّب فما يكون مصحّحاً لتعلّق التكليف هو الملاك والمناط لصحّة العقاب.((2))
إنّ للشيخ الأنصاري(رحمه الله) كلاماً، حاصله: إنّ خبر الواحد إذا تعارض مع خبر آخر، وقلنا بالسببية في باب حجّية الخبر بمعنى قيام المصلحة في نفس العمل به، يكون من
ص: 222
قبيل المتزاحمين فيتقيّد إطلاق دليل حجّية کلّ منهما بعدم الآخر من غير أن يسقط أصل الخطاب، وبهذا يرتفع محذور التزاحم.((1))
وأورد عليه بعض المعاصرين(رحمه الله)((2)) - على ما في تقريرات بحثه - بأنّ هذا التزام بخطابين يكون کلّ منهما مترتّباً على عدم امتثال الآخر وليس هذا إلّا الالتزام بالترتّبين فضلاً عن الالتزام بترتّب واحد، والحال أنّ الشيخ ممّن ينكر إمكان الترتّب ويلتزم بسقوط الأمر بالمهمّ.((3))
هذا خلاصة ما أفاده المعاصر المزبور رداً على الشيخ(رحمه الله). ولكنّك بعد التأمّل في كلام الشيخ(رحمه الله) تعرف عدم ورود هذا الإشكال على كلامه؛ فإنّ مراد الشيخ أنّه بعد الالتزام بالسببية ووجود المصلحة في نفس العمل بالخبرين المتعارضين يرجع التعارض بينهما إلى التزاحم ونتيجته تقييد إطلاق دليل کلّ منهما بعدم الآخر، وهذا عبارة اُخرى عن التخيير العقلي، وبهذا يرتفع محذور التزاحم من غير أن يسقط الخطابين من الأصل.
وبعبارة أخرى: لا يكون مراد الشيخ(رحمه الله) من تقييد کلّ من الإطلاقين بعدم الآخر
ص: 223
تقييد کلّ منهما بعصيان الآخر، كما هو الحال في مسألة الترتّب حتى يكون کلّ واحد منهما مترتّباً على الآخر كما ظنّه هذا المحقّق المعاصر(رحمه الله)، بل مراده تعيّن کلّ واحد منهما في ظرف عدم الآخر بما أنّه عدم للآخر لا بما أنّه عصيان له. ولعلّ هذا هو محلّ التأمّل عند السيّد الشيرازي(قدس سره) ووجه عدم التزامه بالعقابين.
نعم، لو كان عدم الآخر بمعنى التمرّد والعصيان يكون وجوب العمل بکلّ واحد منهما مشروطاً بعصيان الآخر ويتّجه الإشكال، ولكن تفسير كلامه بهذا واضح البطلان.
هذا خلاصة الكلام في المقام ونسأل الله التوفيق وعليه التكلان.
ص: 224
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا؟((1))
إعلم: أنّ هذا البحث قد انقلب عمّا هو عليه أوّلاً، ضرورة أنّه لا معنى للبحث عن هذا العنوان ولا محصّل له، بل محصّله لا يكون إلّا التناقض؛ فإنّ مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط وهو الأمر، فيكون محصّل العنوان: أنّ مع فرض عدم الأمر هل يجوز الأمر أو لا؟ وليس هذا إلّا التناقض. فالصحيح في عنوان المسألة أن يقال: هل يجوز للآمر الأمر مع كون أمره واجداً لشرائطه حين الأمر ولكنّه يعلم انتفاء بعض شرائطه عند مجيء وقت العمل به، كما في أمره مع علمه بالنسخ عند حضور وقت العمل مثل:
ص: 225
أمره تعالى بذبح إبراهيم - على نبيّنا وآله وعليه السلام - ولده مع علمه تعالى بفقدان شرطه وقت العمل، فإنّه ربما يكون من شرائط وجوبه عدم وجود الفداء.
إذا عرفت ما يمكن أن يرجع إليه البحث وعنوان الكلام فاعلم: أنّ الأشاعرة لمّا ذهبوا إلى الكلام النفسي وأنّه غير الإرادة النفسانية((1)) التزموا بجواز ذلك؛ لأنّه لا مانع من تعلّق الطلب النفسي على هذا بأمر يعلم الآمر فقدان شرطه عند حضور وقت العمل.((2)) وأمّا المعتزلة: فقد ذهبوا إلى عدم جواز ذلك؛((3)) فإنّهم نفوا وجود صفة قائمة بالنفس غير الإرادة وسائر الصفات المعروفة، فبناءً عليه لا يمكن تعلّق الإرادة بشيء كان الآمر عالماً بفقدان شرط أمره قبل حضور وقت العمل. وأمّا قضيّة إبراهيم(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) وأمثالها فقد أسلفنا الكلام في تحقيقه، فتدبّر.
ص: 226
لا يخفى: أنّ قدماء الاُصوليّين من العامّة حيث عرّفوا الواجب على سبيل الإطلاق بأنّه: هو الّذي يستحقّ فاعله الثواب وتاركه العقاب؛((1)) أشكل عليهم الأمر في الواجب التخييري، لأنّه بناءً على تعريفهم لا يوجد جامع بينه وبين الواجب التعييني؛ فإنّ التخييري على فرض كونه واجباً لا يكون بحيث يستحقّ تاركه العقاب، فلا يصدق عليه ما ذكروه في تعريف مطلق الواجب.
وأمّا أصحابنا الإمامية - رضوان الله عليهم - فقد أدركوا حقيقة الأمر، وأنّه ليس جامع بينهما، وأنّ الوجوب التعييني حقيقته تحتّم المولى عبده بإتيان شيء وإلزامه له، والتخييري إلزامه وتحتّمه عبده بإتيان شيئين أو أشياء على سبيل الترديد النفس الأمري. ولأجل ذلك قالوا في تعريف الواجب التخييري: بأنّه الّذي يكون تاركه لا إلى بدل مستحقّاً للعقاب.((2))
ص: 227
فظهر من ذلك: أنّ حقيقة الوجوب التخييري إيجاب شيئين أو أشياء على سبيل الترديد النفس الأمري، والوجوب التعييني على نحو التعيين والتنجيز.
ولا يخفى: أنّ مراد الأصحاب بالبدل المذكور في تعريف الواجب التخييري ليس البدل الّذي يكون مقابلاً للأصل كما هو المصطلح، بل المراد هو الفرد التخييري كما هو واضح.
ثم إنّه قد يفصل بين الواجب التخييري كما في الكفاية((1)) بأنّه يمكن أن تكون المصلحة المترتّبة على کلّ واحد من الشيئين أو الأشياء عين المصلحة الّتي تترتّب على غيره. فلو تعلّق الأمر بکلّ واحد من الشيئين أو الأشياء على سبيل التخيير يكون بمناط ترتّب تلك المصلحة الواحدة على کلّ واحد منها، ولابدّ من كون الواجب في هذا الفرض الجامع بينها وتعلّق الوجوب به تعييناً، فالتخيير بين أفراد هذا الجامع يكون عقلياً.
ويمكن أن تكون لکلّ واحد منها مصلحة خاصّة لا تكون في الآخر، ولكنّ المصلحتين تكونان بحيث لو أتى بأحدهما لا يبقى مجال لإتيان الآخر ويسقط ما يكون في غيره من المصلحة، بحيث يكون الإتيان بکلّ واحد منها مانعاً عن حصول مصلحة الآخر لو اُتي به أيضاً، فالتخيير في هذه الصورة يكون شرعياً، كخصال الكفّارة.
هذا، ولكنّك خبير بأنّه يمكن فرض مصلحة خاصّة لکلّ فرد من الأفراد حتى في الصورة الاُولى كما يمكن في الصورة الثانية وذلك بمقتضى الدليل، فإنّ الأمر يتعلّق بکلّ واحد منهما على حدة، فأين هذا من كشف الجامع بينهما بحيث يكون متعلّق الأمر هو الجامع؟ فتأمّل.
ص: 228
وقع الخلاف في إمكان التخيير بين الأقلّ والأكثر.((1))
ولا يخفى: أنّه لابدّ من فرض النزاع فيما إذا كان الأكثر مشتملاً على الأقلّ، وهذا هو معنى الأقلّ والأكثر؛ فالزيادة الّتي تزيد على الأقلّ إمّا أن تكون من جنس المزيد عليه وهذا كالطبائع المشكّكة الّتي لها أفراد مختلفة في الشدّة والضعف والطول والقصر والأوّلية والآخرية، وإمّا أن لا تكون كذلك بل الزيادة تكون مباينة للأقلّ، فيكون الأقلّ والأكثر من قبيل المتباينين.
والحاصل: أنّ محلّ النزاع يكون فيما إذا كانت الجهة المشتركة هي الجهة المائزة، سواء كانت من قبيل الكمّيات المنفصلة كالأعداد، أو المتّصلة كالخطّ. مع فرض أنّ موضوع النزاع هو ذات الأقلّ والأكثر، لا بما أنّ الأقلّ له حدّ عدمي هو عدم وجدانه للزيادة وأخذه بشرط لا؛ إذ حينئذٍ يصير من قبيل المتباينين تباين الماهية بشرط لا مع الماهية بشرط شيء، فيخرج عن محلّ النزاع.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّه قد يقال في تقريب التخيير: بأنّه إذا كان الأقلّ محصّلاً للغرض والأكثر أيضاً محصّلاً له بحيث يكون إذا وجد الأقلّ وجد الغرض بتمامه، وإذا وجد الأكثر وجد الغرض بتمامه أيضاً، ويكون الأقلّ في ضمن الأكثر جزءً للمحصّل، فتخصيص الوجوب بخصوص الأقلّ أو الأكثر يكون بلا مخصّص لا محالة؛ بداهة أنّه إذا كان الخطّ الطويل كالقصير محصّلاً لتمام الغرض يكون تخصيص الوجوب بأحدهما دون الآخر تخصيصاً من غير مخصّص، هذا في الكمّيات المتّصلة.
ص: 229
وأمّا الكمّيات المنفصلة أو المتّصلة الّتي يتخلّل فيها العدم، فهي أيضاً كذلك؛ لأنّ الغرض إنّما يترتّب على الأقلّ لو لم يضمّ إليه الأزيد، ولو انضمّ إليه الأزيد فلا يترتّب عليه بل يترتّب على فرد آخر وهو الأكثر. هذا ملخّص تقريب القول بالتخيير.
ولكنّك خبير بأنّه لو كان الأقلّ والأكثر من الكمّيات المنفصلة أو ممّا يتخلّل فيه العدم، كالخطّ الّذي يقطع في حدّ مّا، فيحصل الغرض بمجرّد حصول الأقلّ، فلايصحّ فرض التخيير بينهما أصلاً.((1))
نعم، يمكن أن يقال: بأنّه لو كانت للطبيعة الجامعة خصوصية ملازمة للأقلّ وخصوصية اُخرى ملازمة للأكثر، كالصلاة المخصَّصه بالخصوصيّة السفرية أو الحضرية تكون في الأقلّ مصلحة لا تكون في الأكثر وفي الأكثر مصلحة لا تكون في الأقلّ إلّا أنّ كلّا من المصلحتين لو حصلت توجب سقوط الاُخرى. ويمكن أن تكون التسبيحة من هذا القبيل، فإنّها لو لوحظت بماهي هي وبما أنّها تسبيحة من غير ضمّ خصوصية بها لايمكن تصوّر التخيير بين الأقلّ والأكثر فيها؛ لأنّ الغرض يحصل بأوّل تسبيحة صدرت من المكلّف ولا تصل النوبة إلى الأكثر. وأمّا إذا لوحظت مع خصوصية وبما أنّ في إحداها مصلحة خاصّة وفي الثلاثة مصلحة اُخرى لامانع من تصوير التخيير بينهما حينئذٍ. هذا كلّه فيما إذا كان على نحو الانفصال كما في التسبيحات، أو الاتّصال مع تخلّل العدم فيه.
وأمّا لو لم يكن كذلك وكان متّصلاً من غير تخلّل عدم في اتّصاله، فلا يبعد صحّة التخيير بينهما مطلقاً ولو لم يكن کلّ من الأقلّ والأكثر ملازماً لعنوان ذي مصلحة خاصّة؛ فإنّ الخطّ الطويل يكون فرداً واحداً من الخطّ، والقصير أيضاً فرداً منه، فما دام لم يتخلّل العدم في رسمه يكون شيئاً واحداً غير الآخر، قصيراً كان أو طويلاً، فتدبّر.
ص: 230
الواجب الكفائي هو: الواجب الّذي توجّه الخطاب به إلى كلّ واحد من المكلّفين، ولكنّه يسقط لو أتى به واحد منهم.
وقد اختلفت كلماتهم في تصويره،((1)) فيظهر من بعضها: أنّ الخطاب فيه توجّه إلى تمام المكلّفين بعنوان المجموع من حيث المجموع ويسقط بإتيان فرد واحد منهم.
ويظهر من البعض الآخر من الكلمات: أنّ الخطاب متوجّه إلى واحد من المكلّفين كما هو الشأن في الواجب التخييري، وإنّما الفرق بينهما: أنّ الترديد في الواجب التخييري في ناحية متعلّق التكليف، وفي ما نحن فيه في ناحية المكلّفين.((2)) فكما لا مانع من تصوير الترديد في ناحية متعلّق التكليف، لا مانع من تصويره في جانب المكلّفين أيضاً.
وذهب بعضهم إلى: أنّ الخطاب في الواجب الكفائي متوجه إلى كل فرد فرد من
ص: 231
المكلّفين على سبيل الاستغراق، إلّا أنّ الخصوصية في الواجب الكفائي تكون في ناحية السقوط وهذا بحيث لو أتى به أحد منهم سقط من السائرين.((1))
إنّك خبير بفساد التعاريف المذكورة.
أمّا التعريف الأوّل، ففيه: أنّ عنوان المجموع ليس عاقلاً حتى يصحّ توجيه الخطاب إليه.
وأمّا التعريف الثاني، فلو كان المراد بواحد منهم مفهومه فيرد عليه الإشكال الأوّل. ولو كان المراد به مصداق أحد منهم فالترديد لا يعقل في جانب المكلّفين؛ لأنّ توجيه الخطاب لابدّ وأن يكون نحو شخص معيّن، إذ لا يمكن تحريك الشخص المردّد وبعثه نحو الفعل. وهذا بخلاف الترديد في جانب المتعلّق، إذ الغرض كما أنّه يترتّب تارة على متعلّق واحد كذلك يمكن أن يترتّب على کلّ واحد من المتعلّقات.
وأمّا التعريف الثالث، فيرد عليه: أنّ السقوط إن كان من جهة حصول تمام الغرض بإتيان واحد منهم، فلا مجال لتوجيه الخطاب نحو كلّ فرد فرد من المكلّفين، وإنّما يصحّ نحو واحد منهم.
وإن لم يكن وجه السقوط حصول الغرض، فلا يسقط الأمر؛ لأنّ الغرض إذا لم يحصل بعد إتيان واحد من المكلّفين فلا مجال لسقوط التكليف عن السائرين.
هذا مضافاً إلى أنّه لا يعقل أن يكون امتثال شخص للأمر امتثالاً من شخص آخر أيضاً.
ص: 232
إنّ التحقيق يقتضي أن يقال: إنّ للأمر إضافة إلى الآمر بسبب صدوره منه؛ وإضافة إلى المأمور بتحريكه إيّاه؛ وإضافة إلى الفعل الصادر بقيامه فيه قيام العرض في الموضوع، فكما يمكن أن تكون إضافته إلى الفعل المتعلّق بقيد صدوره عن کلّ فرد من الأفراد مباشرة، كما في الصلاة والصيام، فإنّ الأمر بهما قد توجّه إلى المكلّفين بقيد صدورهما عن کلّ فرد فرد منهم لقيام المصلحة بهذا النحو، كذلك يمكن أن تكون إضافة الأمر إلى المتعلّق لا بنحو صدور ذلك عن کلّ واحد منهم بل كانت إضافته إلى الطبيعة الصرفة لأجل تعلّق الأمر بصرف طبيعة الفعل لا بقيد تكثّرها بتكثّر أفرادها، ومن الواضح أنّ الطبيعة توجد بوجود فردٍ مّا، وبعد وجودها كذلك لا مجال لعدم سقوط الأمر المتعلّق إليها. وهذه حقيقة الواجب الكفائي.
الأوّل: ربما يقال - كما في الكفاية: - بأنّ مقتضى إطلاق الأمر هو أن يكون الواجب عينياً؛ لأنّ الكفائي مقيّد بعدم إتيان الآخر والحال أنّ الإطلاق يقتضي خلاف هذا التقيّد.((1))
ولكن بعدما ذكرنا التحقيق في الوجوب الكفائي لا مجال لهذا القول، فإنّه على ما حقّقناه يقتضي الإطلاق خلاف ذلك؛ لأنّ القيد إنّما يكون في الوجوب العيني لا الكفائي، إذ المفروض أنّ الطبيعة الصرفة العارية عن خصوصية صدورها من الأشخاص هي متعلّقة الأمر في الكفائي، بخلاف العيني فإنّ المتعلّق فيه مقيّد بقيد صدورها عن کلّ فرد فرد من المكلّفين، هذا بحسب الإطلاق.
ص: 233
وأمّا الّذي يقتضيه الظاهر فالإنصاف أنّه خلاف ذلك؛ لأنّ الأمر ظاهر في العيني لا الكفائي وهذا غير الإطلاق.
الثاني: إنّ مقتضى ما هو الحقّ من أنّ الطبيعة تتكثّر بتكثّر أفرادها: هو الامتثالات العديدة فيما يكون الآتي بالواجب الكفائي متعدّداً وامتثلوه دفعة واحدة. وقد أوضحنا ذلك في مسألة المرّة والتكرار بل يكون الأمر في المقام أوضح من هناك، والله تعالى أعلم بالصواب.
ص: 234
إنّ الواجب إمّا مطلق وهو: ما ليس للزمان دخل في حصول مصلحته إذا أتى به، حتى لو فرض حصول الواجب في ما وراء عالم الزمان لا مانع من تحقّق مصلحته.
فعلى هذا، ولو كان الفعل المأمور به من الزمانيات بمعنى ضرورة وقوعه في وعاء الزمان ولكن لا يكون هذا سبباً لدخل الزمان في حصول مصلحته وتقيّد الواجب بزمان خاصّ.
وإمّا موقّت وهو: ما كان للزمان دخل في حصول مصلحته.
وهذا تارة: يكون الزمان الّذي له دخل في حصول مصلحته بمقدار ما يحتاج فعل الواجب إليه من غير زيادة، فهو المضيّق. وتارة: يكون أوسع من ذلك كصلاة الظهر، وهو الموسّع.
فالواجب الموسّع هو الفعل الّذي أمر بإتيانه في القطعة الواسعة من الزمان، فيكون المأمور به طبيعة الفعل الواقعة في تلك القطعة من غير دخالة لوقوعها في أوّلها أو وسطها أو آخرها في حصول المصلحة. فكما تكون للطبيعة أفراد دفعية، تكون للموسّع أيضاً أفراد تدريجية. وكما أنّ المكلّف مختار في إتيان کلّ واحد من أفرادها الدفعية، كذلك هو مخيّر بالنسبة إلى أفرادها التدريجية. وكما أنّ التخيير بين الأفراد الدفعية عقلي، يكون التخيير بين الأفراد التدريجية أيضاً عقلياً.
ص: 235
ولا يخفى: أنّ الواجب الموسّع بهذا المعنى لا يصير مضيّقاً ولا تضيق دائرته بتضييق زمانه؛ لأنّ الموسّع هو الواجب الّذي تعلّق الطلب بإتيانه في تلك القطعة من الزمان، فإن أتى به في أوّل الوقت يقال: إنّه أتى بالمأمور به وكذلك إن أتى به في وسط الوقت أو في آخره، فهو على حاله.
ولا يصحّ أن يقال: إنّه أتى بالفرد المأمور به فيما يأتي به في أوّل الوقت أو آخره، وإنّما هو يأتي بالطبيعة المأمور بها يكون في أوّل الوقت أو آخره أو في ضمن أيّ فرد من هذا الكلّي الممتدّ في قطعة من الزمان. وعليه إذا لم يبق من الوقت إلّا بمقدار لا يكون زائداً على المقدار الّذي يحتاج إليه الفعل من الزمان عقلاً وأتى بالمأمور به في هذا الوقت، فقد أتى بالطبيعة المأمور بها أيضاً بما أنّها موسّعة لا مضيّقة،((1)) لأنّ الطبيعة لا تنقلب عمّا هي عليه، وإنّما الانطباق في هذه الصورة قهريّ عقلاً.
وقع الخلاف في دلالة الأمر بالموقّت على الأمر به في خارج الوقت.
وبعبارة اُخرى: وقع النزاع في فوات الموقّت بفوات وقته وعدمه.
ولا يخفى: عدم دلالة الأمر على مطلوبيته في خارج الوقت لو لم نقل بدلالته على عدمها، وأنّ دليل وجوب الموقّت یدلّ على فواته بفوات وقته. هذا، إذا كان لنا أمر واحد.
وأمّا إذا كان لنا أمر متعلّق بالفعل مطلقاً، وأمر على سبيل التوقيت، فالأمر واضح أيضا؛ لأنّ بعد فوات الموقّت وإن لم يكن للأمر الثاني دلالة على وجوبه في خارج الوقت إلّا أنّ الأمر الأوّل حيث لا يفوت متعلّقه بفوت الوقت فدلالته على مطلوبيته
ص: 236
المطلقة في الوقت وخارجه على حاله. فلا مجال للنزاع في هذين الموردين لوضوح عدم دلالة الأمر في المورد الأوّل، ووضوح دلالة الأمر المطلق في المورد الثاني.
ثم إنّه قد ذكر في الكفاية: أنّه لو كان التوقيت بدليل منفصل ولم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت بل كان لدليل الواجب إطلاق، لكان مقتضى إطلاق الواجب ثبوته ولو بعد انقضاء الوقت.((1))
وفيه: أنّه لا يكاد أن يفهم من ذلك الكلام معنى معقول؛ لأنّه بعد ظهور الدليلين في بيان تمام المطلوب، وأنّه نفس الطبيعة على ما يستفاد من إطلاق دليل الواجب، وأنّه الفعل المقيّد بحصوله في زمان خاصّ على ما يستفاد من إطلاق دليل القيد، يقع التعارض بينهما. وحينئذٍ لا يخلو إمّا أن يكون کلّ من الأمرين غير مرتبط بالآخر ويستفاد من كلّ واحد منهما حكم مستقلّا على حدة، فهذا غير مربوط بالمقام ولا يقع التعارض بينهما؛ وأمّا إن كان كلاهما راجعين إلى حكم واحد ومتكفّلين لبيان حكم واحد، فاللازم بعد إحراز ذلك حمل المطلق منهما على المقيّد، وبعد ذلك لا يبقى لدليل الواجب إطلاق حتى يقال: إنّ قضيّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، فتدبّر.
ص: 237
إعلم: أنّ الاُصوليّين قد اختلفوا في أنّ متعلّق الأوامر هل تكون الطبائع أو الأفراد؟
فذهب بعضهم إلى أنّ متعلّقها الطبائع. والبعض الآخر إلى أنّ متعلّقها الأفراد.
ولا يخفى: أنّ مراد القائل بالطبيعة: أنّ متعلّق الأمر في قولنا: ادخل السوق واشتر اللحم، لا يكون إلّا الجهة الّتي يصدق عليها شراء اللحم من غير دخل لسائر الخصوصيات والحيثيات فيه، فإذا دخل العبد السوق واشترى اللحم فالمصحّح للقول بأنّه امتثل أمر المولى ليس إلّا جهة إتيانه بهذه الحيثية الّتي يصدق عليها شراء اللحم، فتكون هذه الجهة مناطاً لصدق العنوان.
وأمّا مراد القائل بالفرد: أنّ جميع الحيثيات الفردية والجهات المميّزة للفرد تكون واقعة تحت الأمر.
وممّا يؤيّد ما ذكرناه من مراد القائلين بالطبائع: أنّ المجوّز في باب اجتماع الأمر والنهي يقول: إنّ متعلّق الصلاة لا يكون إلّا الجهة الّتي يصدق على الفعل أنّه صلاة، ومتعلّق النهي عن الغصب ليس إلّا الجهة الّتي بها يصدق على العمل أنّه غصب، فتختلف الجهتان فيمكن اجتماعهما في محلّ واحد.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ لمفهوم الأمر - وكلّ لفظ كان مفاده مفاد الأمر كالإلزام
ص: 238
والبعث والإيجاب والطلب - إضافة إلى الّذي يصدر منه الطلب والأمر وهو الآمر؛ وإضافة إلى من يطلب منه الفعل المأمور به وهو المأمور والمطلوب منه؛ وإضافة إلى ما يريد الآمر وقوعه في الخارج وتحقّقه وهو المطلوب والمأمور به.
ويشترط في تحقّق هذه الإضافات أن يكون المأمور موجوداً - حال الطلب والأمر - في الخارج، لاستحالة توجيه الخطاب نحو المعدوم.
وأمّا المأمور به فيشترط أن لا يكون موجوداً في الخارج وإلّا يلزم تحصيل الحاصل. مضافاً إلى أنّ لحاظ الحيثيّات المميّزة لأفراد، غير حاكٍ عن سائر الأفراد المميّزة بحيثيات اُخرى. وحيث إنّه لابدّ من تعلّق الطلب بالمطلوب ولا يمكن اتّصاف الموجود في عالم الخارج بالمطلوبية، فيكون المطلوب بوجوده الذهني مطلوباً ومتعلّقاً لإضافة الأمر إليه، فالآمر حين الأمر يلاحظ الجهة الّتي بسببها ينطبق على الفعل الخارجي الصلاة والصوم مثلاً، من غير أن تكون ملاحظتها في الذهن قيداً لها؛ لأنّه لو لاحظها مقيّدةً بقيد لحاظها في الذهن فلا يكون له موطنٌ إلّا الذهن، فلا يكون حاكياً عن الخارج وعن الجهة الخارجة الّتي بها يصدق على الأفراد الخارجية أنّها مطلوبة.
وبالجملة: ما هو المتعلّق للأحكام ليس إلّا الجهة المشتركة والحيثية الّتي توجد في جميع الأفراد من غير دخل لسائر الحيثيّات والجهات والخصوصيّات الفرديّة والمميّزة، هذا.
ثم إنّه لايخفى: أنّ صاحب الكفاية(قدس سره) ذهب إلى أنّ متعلّق الأحكام ليس إلّا نفس الطبائع من دون نظر إلى الخصوصيات الفردية، ولكن ليس المراد من ذلك زائد عليها وهو المطلوبية، وهذا محال؛ لأنّ الماهية من حيث هي ليست إلّا هي، ولذا قالوا في مبحث
ص: 239
أصالة الوجود: إنّ ارتفاع النقيضين في مرتبة الذات ليس بمحال، فالماهية من حيث هي لا تكون موجودة ولا معدومة، فيصحّ أن يقال: إنّ الإنسان في مرتبة ذاته وماهيّته ليس بعالم وليس بجاهل.
بل مرادهم أنّ متعلّق الطلب وجود الطبيعة، ومتعلّق الأمر نفس الطبيعة، لأنّه بمعنى طلب الوجود. وكذلك النهي يتعلّق بنفس الطبيعة بمعنى طلب تركها.
لا يقال: إذا كان الوجود متعلّقاً للطلب فلا يصحّ القول بعدم مطلوبية الخصوصيات الفردية؛ لأنّه لا يمكن بعد القول ببساطة الوجود تصوّر التفكيك بين وجود تلك الجهة المشتركة وسائر الجهات، لأنّهما موجودان بوجود واحد.
لأنّه يقال: إنّ متعلّق الحكم ليس مطلق الوجود حتى يرد علينا ما ذكر، بل المتعلّق هو الوجود المضاف إلى الطبيعة.
ولا ينبغي توهّم((1)) أنّ مقتضى ما ذكر - من تعلّق الطلب بوجود الطبيعة - أن يكون الطلب متعلّقاً بما هو حاصل وصادر في الخارج وتحصيلاً للحاصل.
لأنّ المراد أنّ الآمر يريد صدور الوجود من العبد وجعله بسيطاً، كما هو مفاد «كان» التامّة، وإفاضته.
كما أنّه لا مجال بعدما ذكر لتوهّم تعلّق الطلب بالطبيعة لأجل وجودها، والنهي بالطبيعة لأجل عدمها حتى يكون وجود الطبيعة غاية لطلبها، وعدمها غاية للنهي عنها.
لأنّه يعود الإشكال المذكور وهو جواز حمل ما هو زائد وخارج عن الذات عليها، هذا كلّه بناءً على أصالة الوجود.
وأمّا بناءً على أصالة الماهية، فمتعلّق الطلب ليس هو الماهية بما هي أيضاً بل بما هي
ص: 240
بنفسها في الخارج، فيطلب الماهية كذلك لكي يجعلها بنفسها - لا بوجودها - من الخارجيات والأعيان الثابتة. انتهى حاصل ما أفاده.((1))
ولكن قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه لا مانع من تعلّق الأمر والطلب بالطبيعة من غير فرق بينهما، فلا وجه لمنعه في الكفاية تعلّق الطلب بها مع اعترافه بتعلّق الأمر بها بتوهّم أنّ الأمر طلب الوجود وأمّا الطلب فلا يمكن أن يكون متعلّقاً بغير الوجود بناءً على القول بأصالة الوجود. وأمّا بناءً على القول بأصالة الماهية فيتعلّق الطلب بالماهية لكن بلحاظ وجودها.
فالحقّ كما ذكرناه: تعلّق الأمر وكذا الطلب بنفس الطبيعة، أي بالحيثية الّتي تدلّ عليها مادّة الأمر، مثلاً في قوله: ﴿أَقيمُوا الصَّلَوةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ﴾((2)) لا يتعلّق الأمر إلّا بالجهة الّتي تصدق عليها أنّها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
لا يقال: إنّ الطبيعة وماهية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أو الضرب أعمّ من أن تكون موجودة أو معدومة فتصدق إقامة الصلاة على تلك الحيثية سواء كانت موجودة أم معدومة، فلا يصحّ أن تكون متعلّقة للطلب وواقعة تحت الأمر، لأنّ الأمر والطلب لا يتعلّقان بأعمّ من الموجود والمعدوم.
فإنّه يقال: لا مجال لهذا الإشكال، إذ الماهيّة في حال كونها معدومة آبية عن صدق المفاهيم عليها ولا يصحّ حمل إقامة الصلاة مثلاً على ما هو المعدوم؛ لأنّ العدم باطل بالذات وليس له استحقاق حمل مفهوم عليه.
وبالجملة: فالعقل وإن كان يرى للضرب الموجود حيثية موجودة، وماهية وجهة
ص: 241
يصدق عليها أنّه ضرب، لكن يراهما في عالم التحليل ممتازاً عن الآخر وإن كانا متّحدين معاً مصداقاً بحيث لا يكون في الخارج إلّا شيئاً واحداً.
ولأجل هذه التجزئة والتحليل يُشكّ في أنّ الصادر من المصدر والمفاض من المفيض، وبعبارة اُخرى: الصادر بالذات هل هو وجود الضرب وتعلَّق الجعل بتبعه إلى الماهيّة كما اختاره القائل بأصالة الوجود، أو أنّ المجعول بالذات والمفاض هو ماهية الضرب وتعلَّق الجعل بتبعها إلى الوجود؟
ولكن مع ذلك كلّه لا يصدق مفهوم الضرب على الماهية المعدومة. ولا مانع من تعلّق الطلب والأمر بالجهة الّتي يصدق عليها مفهوم الضرب أو إقامة الصلاة، فالآمر يطلب إصدار هذه الطبيعة من المكلّف، ولا نظر له إلى أنّ الإصدار يتعلّق أوّلاً بالوجود أو بالماهية.
وأمّا ما في كلامه(رحمه الله) من «أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي»، فغير مربوط بالمقام؛ لأنّ معنى هذه القاعدة أنّ الماهية إذا اُخذت بنفسها ومجرّدة عن جميع الخصوصيات لا يصحّ حمل شيء عليها إلّا ذاتها وماهو جزء ذاتها، مثلاً ماهية الإنسان من حيث هي هي آبية عن حمل جميع المفاهيم عليها إلّا مفهوم ذاتها أو جزء ذاتها، فلا مانع من أن يقال: الإنسان إنسان، أو حيوان، أو ناطق. فلا يصدق عليه - إذا اُخذ موضوعاً - إلّا الإنسان أو الحيوان أو الناطق، ولا يحمل عليه أنّه جاهل أو عالم وشبههما. ولكن عدم صحّة حمل شيء على الماهية من حيث هي هي غير ذاتها أو جزء ذاتها لا ينافي صحّة إضافة شيء وتعلّقه بالماهية من حيث هي هي، فمن الممكن بل الواقع كثيراً إضافة أمر إليها كإضافة التصوّر والعلم والقدرة والطلب. فهذه الاُمور تتعلّق بها من حيث هي هي، وهذا لا ينافي خروجها بعد ذلك من هذه الحيثية واستحقاق الماهية لحمل ما كان زائداً على ذاتها عليها، مثل أن تقول: الطبيعة متصوّرة
ص: 242
أو معلومة أو مطلوبة؛ لأنّ تعلّق القدرة والتصوّر والعلم والطلب قبل عروض تلك الصفات عليها وفي رتبة سابقة عليها.
فظهر ممّا ذكر أنه لا مانع من تعلّق الأمر والطلب بالطبيعة المجرّدة عن جميع الخصوصيات وإن كانت بعد إضافته إليها تستحقّ حمل أنّ-ها مطلوبة. والله تعالى أعلم بالصواب.
ص: 243
الفصل الأوّل : في مفاد الأمر والنهي
الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهي
الفصل الثالث: في اقتضاء النهي للفساد
ص: 244
ص: 245
إعلم: أنّ المحقّق الخراساني(قدس سره) وإن ذهب في الكفاية إلى عدم الفرق بين مفاد الأمر والنهي، وأنّ کلّ واحد منهما بمادته وصيغته لا دلالة له إلّا على الطلب، غير أنّ متعلّق الطلب في الأمر وجود الطبيعة، وفي النهي عدمها، فلا تفاوت في مفادهما أصلاً.
وحيث إنّ متعلّق الطلب في الأمر يكون وجود الطبيعة فلو أتى المكلّف بفردٍ منها يتحقّق به الامتثال؛ لأنّ الطبيعي يوجد بوجود فردٍ من أفراده. وفي جانب النهي حيث إنّ متعلّق الطلب يكون عدم الطبيعة فلا يتحقّق الامتثال إلّا بعدم جميع أفرادها. فإطاعة أمر المولى تتحقّق بإيجاد فردٍ من الطبيعي، وعصيانه لا يتحقّق إلّا بترك جميع الأفراد. وإطاعة نهيه لا تتحقق إلّا بترك جميع أفراد الطبيعي، ومعصية نهيه تتحقّق بوجود فردٍ من أفراده.((1))
ولكنّه يلزم من ذلك أوّلاً: لو نهى المولى عبده عن شرب الخمر مثلاً، فأطاعه ولم يشرب الخمر في هذا اليوم مع شدّة ميله إليه، وكذا لم يشربه في الغد، وهكذا أن يعدّ کلّ ذلك امتثالاً واحداً. أو نهاه عن أكل مائدة شخص، فدعاه إليها فلم يجبه لأجل نهي المولى، ثم دعاه بعد ذلك اليوم فلم يجبه، وهكذا لم يجبه في جميع الأيّام مراعاة لنهي المولى أن يكون کلّ ذلك امتثالاً واحداً.
ص: 246
وثانياً: لو عصا العبد نهي المولى فأتى بفردٍ من أفراد المحرّم، ثم أتى بعد ذلك بفردٍ آخر منه لم يكن على هذا المبنى إتيانه بالفرد الثاني عصياناً.
وثالثاً: لو امتنع من شرب الخمر المنهيّ عنه في يوم وشربه في يوم آخر لا يكون بالنسبة إلى امتناعه عنه ممتثلاً.
والعقلاء في أحكامهم يخالفون جميع هذه اللوازم، ويكون ديدنهم في باب الإطاعة والعصيان منافياً لها بأشدّ المنافاة، وهذا كاشف عن إختلاف مفاد الأمر والنهي خلافاً لما ذكره صاحب الكفاية(قدس سره).
والّذي يقتضيه التحقيق:((1)) أنّ الأمر والنهي مختلفان بحسب الحقيقة والأثر؛ وذلك لأنّ حقيقة الأمر عبارة: عن البعث نحو الفعل وتحريك المأمور إليه، وحقيقة النهي هي: الزجر عن الفعل والمنع عنه.
وبعبارة اُخرى: حقيقة الأمر: ما يقال له بالفارسية «وا داشتن، وادار كردن»، وحقيقة النهي: ما يقال له بهذه اللغة «باز داشتن». فالآمر إذا رأى في فعل مصلحة عائدة إلى نفسه أو إلى المأمور يصير ذلك الفعل محبوباً له فيبعث المكلّف نحوه. وإذا رأى في فعلٍ مفسدة عائدة إلى نفسه أو إلى عبده يصير ذلك الفعل مورداً لبغضه فيزجر عبده عن إتيانه. هذا اختلافهما بحسب المبدأ والحقيقة.
وأمّا اختلافهما بحسب الأثر من حيث الامتثال والعصيان،((2)) فهو بمكان من
ص: 247
الوضوح؛ فإنّ المولى إذا أمر عبده بفعل فأتى بفردٍ منه، يحكم العقلاء بامتثال أمره وسقوطه وحصول غرضه. وهذا بخلاف جانب النهي؛ فإنّهم لا يحكمون بسقوط النهي لو انزجر المكلّف عن فردٍ من أفراد المنهيّ عنه.
كما أنّهم لا يحكمون بعصيان الأمر لو لم يكن لمتعلّقه وقت أو كان ولكن كان موسّعاً ولم يأت المكلّف به في قطعة من الزمان. وفي جانب النهي يحكمون بالامتثالات العديدة لو انزجر من النهي وترك فرداً من الطبيعة المنهيّ عنها ثم ترك غيره من الأفراد وكان تركه لهذه الأفراد مع ميله واشتهائه إلى فعلها. ولا يحكم بالامتثال لو ترك جميع أفراد المنهي عنه أو بعضها مع عدم الميل أو الاشتهاء، بل يعدّ هذا موافقة للنهي لا إطاعته وامتثاله.
وأيضاً في جانب الأمر لو أتى بجميع الأفراد العرضية دفعة واحدة بقصد الامتثال يحكم بالامتثال والإطاعة بالنسبة إلى جميع الأفراد، دون ما إذا لم يقصد الامتثال إلّا بترك واحد منها، فلا يحكم بالامتثال إلّا بالنسبة إلى هذا الّذي قصد بإتيانه امتثال الأمر وإن صار الجميع متروكاً.
كما أنّه لا مجال للحكم بالامتثال إذا أتى بالأفراد التدريجية بعد الإتيان بواحد منها؛ لأنّ الغرض يحصل بوجود أوّل فرد من الطبيعة، فلو كان الأمر بعد ذلك باقياً على حاله يلزم تحصيل الحاصل.
وكذلك يحكمون بالعصيان وحصول المخالفة لو أتى بفرد من أفراد المنهيّ عنه بعد تحقّق العصيان والمخالفة بإتيانه بفرد آخر منه قبله؛ ووجه ذلك أنّ زجر المولى عبده عن الطبيعة يقتضي ترك إتيان كلّ فرد من أفرادها بحيث لو عصاه بالنسبة إلى فرد أو أطاعه يرى زجره عنها باقياً على حاله.
وأيضاً متعلّق الأمر والبعث في الأمر لا يكون إلّا ما به تحصل موافقة الأمر كإيتاء
ص: 248
الزكاة وإقامة الصلاة، ومتعلّق النهي على خلاف ذلك؛ لأنّه يكون ما به تتحقّق المخالفة كشرب الخمر والزنا. وهذا أيضاً يقتضي تخالفهما في الأثر؛ لأنّ على ذلك حصول الموافقة يتحقّق بإيجاد كلّ فردٍ من أفراد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وتحقّق المخالفة في جانب النهي يكون بالإتيان بکلّ فردٍ من أفراد الزنا وشرب الخمر. فالأوّل لا يقتضي إلّا وجوب الإتيان بفردٍ واحدٍ وكفاية الإتيان به في مقام الامتثال، وتحقّق العصيان بترك جميع الأفراد. والثاني يقتضي الاجتناب عن جميع الأفراد، وتحقّق العصيان بسبب الإتيان بکلّ فردٍ من أفراد المنهيّ عنه عصياناً مستقلاً بالنسبة إلى کلّ منها. وهكذا الكلام في جانب امتثال النهي.
لا يقال: إنّ ما ذكرته من تكثّر العصيان في جانب النهي صحيح لو اُخذت الطبيعة المتعلّقة للنهي مطلقة، أي بنحو الإرسال، وأمّا لو اُخذت في لسان الدليل مهملة، فلا.((1))
فإنّه يقال: إنّ هذا كلام أجنبيّ عن المقام وسيجيء البحث عنه إن شاء الله تعالى في المطلق والمقيّد؛ وذلك لأنّ الكلام في المقام إنّما يكون فيما إذا كانت الطبيعة تمام متعلّق الأمر والنهي وكانت في موضوعيتها للحكم تامّة وهذا يكون ملاك الإطلاق كما سنحققه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الأوّل: لو ترك المنهيّ عنه من غير اشتهاء وميل إليه، بل كما يتّفق كثيراً من غير التفات، لا يعدّ تركه هذا إطاعة للمولى وإن كان هذا الترك موافقة للنهي. فالامتثال وعدمه في صورة الموافقة راجع إلى اشتهائه وعدمه وكفّ النفس عن فعل المنهيّ عنه وعدمه، كما لا يخفى.
ص: 249
الثاني: ربما يتّفق في بعض الموارد الأمر بما كان من الاُمور العدمية، وتردَّد بعض من الأعلام في كونه أمراً أو نهياً، كما إذا تعلّق الأمر بأمر عدميّ كالإمساك، فتردَّد في أنّ حقيقة هذا الأمر هل هي راجعة إلى النهي عن إتيان المفطرات الخاصّة، أو هو أمر حقيقة كما أنّه كذلك بحسب الظاهر؟
ولكن لا يخفى عليك: أنّ في هذه الموارد يكون متعلّق الأمر أمراً وعنواناً وجودياً ملازماً لهذا الأمر العدمي.
تلخّص ممّا ذكر أنّ اختلاف الأمر والنهي راجع إلى حقيقتهما، ولازم ذلك تحقّق الإطاعة في جانب الأمر بمجرّد الإتيان بفردٍ من الطبيعة؛ لأنّ ما هو تمام متعلّق البعث يكون وجود الطبيعة على نحوٍ ذكرناه في مبحث الطبائع والأفراد، فبمجرّد الإتيان بفردٍ من الطبيعة تتحقّق الإطاعة ويسقط الأمر، ولا يتحقّق العصيان إلّا بترك جميع الأفراد.
وأمّا في جانب النهي، فالعصيان يتحقّق بإتيان کلّ فردٍ من أفراد الطبيعة؛ لأنّ لازم الزجر عن وجود الطبيعة - حسب ما حقّقناه في البحث السابق - تحقّق العصيان بالإتيان بکلّ فردٍ من أفراد الطبيعة المنهيّ عنها، فهذا الفرد مزجور عنه وذاك أيضاً مزجور عنه وهكذا.
وهذا الاختلاف غير مرتبط بمتعلّقيهما؛ فإنّه في جانب الأمر والنهي واحد، فالزجر متعلّق بالوجود كما أنّ الأمر أيضاً متعلّق به.
نعم، ما به تحصل الموافقة في جانب الأمر هو عين ما تحصل به المخالفة في جانب النهي. فمتعلّق الأمر في «أقيموا الصلاة» و«آتوا الزكاة» يكون وجود إقامة الصلاة
ص: 250
وإيتاء الزكاة، وبهما تحصل الموافقة. ومتعلّق النهي في «لا تزن» و«لا تشرب» هو وجود الزنا والشرب، وبهما تتحقّق المخالفة.
وأمّا الامتثال فيتحقّق بترك کلّ فردٍ من أفراد المنهيّ عنه مع الميل إليه واشتهائه به، فبالنسبة إلى ترك کلّ فردٍ إذا تركه كذلك امتثل نهي المولى، وأمّا لو لم يكن له ميل إلى المنهيّ عنه فبمجرّد تركه لا يكون ممتثلاً وإن كان هذا موافقة لنهي المولى.
لا يقال: بناءً على هذا يلزم أن لا يكون العصيان مثل الامتثال مسقطاً للتكليف وأن يكون النهي بعد العصيان بسبب الإتيان ببعض الأفراد باقياً على حاله.
لأنّه يقال: سيأتي تحقيق ذلك في آخر هذا المبحث((1)) بأنّ القول بسقوط التكليف بالعصيان فاسد جدّاً، فلا مجال إلّا القول ببقاء النهي على حاله لو تحقّق عصيان المكلّف بالنسبة إلى بعض الأفراد دون غيره.
لا يخفى عليك: أنّه وإن وقع النزاع بينهم في أنّ متعلّق الطلب في النهي هل هو الكفّ،((2)) أو مجرّد الترك وأن لا يفعل؟((3)) ولكن لا وقْع لهذا النزاع بعدما حقّقنا معنى الأمر والنهي بأنّ مفاد النهي ليس الطلب حتى يأتي هذا النزاع بأنّه طلب الكفّ أو مجرّد الترك، بل مفاده إنّما هو الزجر عن وجود الطبيعة.
ولا يمكن أن يقال: يصحّ جريان هذا النزاع من جهة الأمر بالنقيض الّذي ينتزع
ص: 251
من النهي، كما ذكر في مبحث الضدّ بالنسبة إلى الأمر((1)) - في مقام بيان ملاك القول بعينية الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه - بأنّه وإن كان حقيقة الأمر البعث إلى الوجود ولكن ينتزع منه النهي عن نقيضه وهو العدم، لا بمعنى أنّ هذا النهي مغاير للأمر ولا بمعنى عينيته للأمر بل هو متّحد مع الأمر بنحو من أنحاء الاتّحاد بحيث ينتزع العقل من الأمر ذلك ويحكم باتّحادهما وجوداً وحمل أحدهما على الآخر بالحمل الشائع الصناعي الّذي ملاكه الاتّحاد في الوجود، فالأمر يكون غير النهي المنتزع منه مفاداً ومفهوماً ومتّحداً معه مصداقاً.
لأنّه يقال: وإن كان لا مانع من تصوير ذلك في النهي أيضاً ببيان أنّ النهي وإن كان حقيقته الزجر عن وجود الطبيعة ولكن ينتزع العقل من النهي الأمر بالنقيض وهو عدم الطبيعة، لكن لا بمعنى أنّ هذا عين النهي ولا أنّ هذا مغاير له بل هو متّحد معه بنحو من أنحاء الاتّحاد وينتزع ذلك منه عقلاً؛ ولكن لا يفيد ذلك لإجراء البحث المذكور، فإنّ الأمر المنتزع عن النهي ليس متعلّقه إلّا عدم الطبيعة ولا يقيّد بكونه عدم الخاصّ أي عدم الطبيعة الملازم للرغبة إلى الوجود؛ لأنّ نقيض الوجود العدم المطلق لا المقيّد. والحاصل: أنّ النهي لا يتّحد مع الكفّ أصلاً حتى يأتي النزاع المذكور، فتدبّر.
يمكن أن يقال بإمكان تقسيم النهي إلى التوصّلي والتعبّدي((2)) لو قيل بأنّ مفاد النهي هو طلب ترك الطبيعة، فإنّه كما يمكن طلب
ص: 252
تركها مطلقاً، كذلك يمكن طلب ترکها مقيّداً بقصد القربة. وأمّا بناءً على ما اخترناه من كون مفاده الزجر عن الوجود،((1)) فلا يصحّ هذا التقسيم.((2))
لا يذهب عليك: أنّه وإن اشتهر بينهم أنّ مسقط التكليف أمران،((3)) أحدهما: الإطاعة والموافقة. وثانيهما: العصيان والمخالفة، ولكنّ الصواب أنّ العصيان والمخالفة في جانب الأمر لا يكون سبباً لسقوط الأمر، بل إنّما يكون سببه أمراً آخر يوجد في ظرف العصيان وهو امتناع الإتيان بالمأمور به، كما إذا أمره بفعل في زمان معيّن ولم يأت المكلّف به حتى خرج الوقت، فسقوط الأمر لا يكون من جهة العصيان بل من جهة خروج الوقت وامتناع الإتيان بالمأمور به.
أو تكون علّة سقوطه امتناع بقاء التكليف، كما في الموسّعات فيما إذا لم يأت المكلّف بالواجب حتى مات، فسقوط التكليف راجع إلى استحالة تكليف الموتى.
ومن هذا يظهر وجه عدم سقوط النهي بمجرّد تحقّق العصيان بالنسبة إلى أحد أفراد المنهيّ عنه كما أشرنا إليه. والله تعالى أعلم بالصواب.
ص: 253
قد أشرنا في طيّ المباحث السابقة((1)) إلى أنّ لکلّ تكليف إضافة ونسبة إلى المكلّف وهو الآمر؛ وإضافة إلى المكلّف به وهو الحيثية الّتي تعلّق البعث إليها في الأمر، والزجر عنها في النهي؛ وإضافة إلى المكلّف وهو المأمور. فبدون تلك الإضافات لا يعقل تحقّق التكليف، فلا يتحقّق التكليف إلّا إذا وجد جميع هذه الإضافات، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح.
ولا يخفى عليك: عدم إمكان تعلّق الأمر والنهي والبعث والزجر من شخص واحد إلى حيثية واحدة متوجّهاً إلى مكلّف واحد في آن واحد. ففي صورة وحدة التكليف ووحدة زمانه ووحدة المكلّف لا يعقل جواز اجتماع الأمر والنهي.
وبعبارة اُخرى: امتناع اجتماع تلك الإضافات، أي توجه الأمر والنهي والبعث والزجر من جانب شخص واحد إلى مكلّف واحد في متعلّق واحد، وفي آن واحد من البديهيات. وامتناع اجتماع تلك الإضافات ليس من جهة صيرورته تكليفاً بالمحال
ص: 254
لأجل عدم قدرة المكلّف على إتيان هذه الحيثية وتركها في زمان واحد، بل امتناعه راجع إلى نفس التكليف من جهة استحالة البعث والزجر نحو شيء واحد في مرتبة واحدة من جانب شخص واحد إلى شخص واحد.
نعم، لا مانع من تعلّق البعث والزجر بحيثية واحدة وتوجيههما إلى مكلّف واحد إذا كان الباعث غير الزاجر، فأحدهما يزجره عن هذه الحيثية والآخر يبعثه نحوها. كما أنّه لا مانع من التكليف في صورة تعدّد متعلّقه ولو كان الآمر والزاجر واحداً والمأمور أيضاً واحداً. وكذلك لا مانع من أمر المولى أحد عبيده بفعل وزجره عبده الآخر منه. وأمّا بدون هذه الجهات المفرِّقة فلا يمكن زجر مكلَّف واحد عن حيثية واحدة في آن واحد من مكلِّف واحد مع بعثه إليها كذلك.
ومن هنا يظهر أنّ النزاع في مبحث اجتماع الأمر والنهي لا يكون إلّا صغروياً، فبعد تسلّم امتناع الاجتماع على النحو المذكور عند الكلّ، اختلفوا في أنّ المولى إذا أمر عبده بحيثيّة وبعثه نحوها ونهاه عن حيثية اُخرى وكانت النسبة بينهما عموماً من وجه أو مطلقاً فجمع العبد في مقام الإتيان بين تلك الحيثيتين، هل يكون ممتثلاً من جهة إتيانه بتلك الحيثية المبعوث إليها وعاصياً من جهة الإتيان بالحيثية المزجور عنها أو لا؟ بل يكون هذا من صغريات الكبرى المذكورة الّتي امتناعها من الضروريات، فيحكم العقل باستحالة ذلك من جهة دخوله تحت هذه الكلّية؟
وبعبارة اُخرى: بعد فرض توافق عقول الكلّ على استحالة توجيه البعث والزجر في مرتبة واحدة من المولى الواحد إلى المكلّف الواحد، هل يلزم الخروج عن تحت هذه القاعدة الكلية من تباين الحيثية الّتي وقعت متعلّقة للأمر مع الحيثية المتعلّقة للنهي أو لا؟
فالقائل بالامتناع يقول: إذا كانت الحيثية الّتي تعلّق الأمر بها قابلة لأن يجمع المكلّف بينها وبين الحيثية المزجور عنها بإتيان فردٍ يكون منطبق تلك الحيثيتين ومجمع العنوانين
ص: 255
واختار بسوء اختياره هذا الفرد، يكون الفرد متعلّقاً للبعث من جهة كونه منطبقاً للحيثية المأمور بها ومتعلّقاً للزجر من جهة كونه منطبقاً للحيثية المزجور عنها، فيكون تعلّق البعث إليه في رتبة تعلّق الزجر به، فيدخل تحت الكلّية الضرورية وهي امتناع اجتماع الأمر والنهي في رتبة واحدة واختلاف الحيثيتين لا يرفع الاجتماع الممتنع.
وأمّا القائل بالجواز، فيقول: إنّ إتيان المكلّف بفردٍ ينطبق عليه كلّ من الحيثيتين والعنوانين لا يكون سبباً لتعلّق الأمر والنهي بهذا الفرد، فالبعث والزجر على حالهما ليس لمتعلّق کلّ منهما مساسٌ بالآخر، فلا يكون الأمر بحيثية والزجر عن حيثية اُخرى - تكون النسبة بينهما عموماً من وجه - من صغريات الكلية الضرورية.
هذا كلّه في تحرير محلّ النزاع، وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ كثيراً من إفادات القوم في هذا المقام تطويلات لا طائل تحتها. ومنشأ ذلك تفسيرهم العبارة المعروفة في كتبهم في عنوان البحث من أنّه «هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيءٍ واحد من جهة واحدة أو لا؟» فاختلفوا في معنى الجواز المذكور في هذا العنوان، بأنّه بمعنى الإمكان العقلي أو الوقوعي. وفي معنى الاجتماع، بأنّه ليس الاجتماع الآمري، وهو توجّه الأمر والنهي من جانب المولى إلى عبده بالنسبة إلى شيء واحد، فإنّ هذا واضح الامتناع. بل المراد به الاجتماع المأموري، وهو فيما إذا كان للحيثية المأمور بها فرد يكون منطبقاً للحيثية الّتي تكون منهيّاً عنها واختار المأمور ذلك المصداق للحيثيتين.
واختلفوا أيضا في أنّ المراد من الأمر والنهي هل يعمّ الأمر والنهي الغيريين، أو لا يشمل إلّا النفسيين؟ وفي أنّ المراد منهما هو الأمر والنهي التعيينيّان أو يعمّهما والتخيريين؟ وكذلك في أنّ المراد منهما الأمر والنهي العينيّان أو يعمّهما والكفائيين؟
وأيضاً اختلفوا في ما هو مرادهم بالواحد، بأنّ المراد به الواحد الشخصي أو الجنسي والنوعي والصنفي أو ما هو أعمّ منها؟
ص: 256
وكذلك تکلّموا في ما هو المراد من الجهة، وفي معنى الجهة التقييدية والجهة التعليلية.
والحال أنّه ليس لنا تضييع الوقت لأجل تفسير تلك العبارة الّتي هي سترة للواقع وحجاب يمنع المحصّلين عن الوصول إلى روح المقصود.
والمحقّق الخراساني(رحمه الله) وإن كان في مقام تلخيص الاُصول وإلغاء القشور والزوائد وأخذ ما هو اللبّ في جميع المطالب، ولكن قد وقع في هذا المقام وغيره فيما كان يفرّ منه، فما صار كتابه مصوناً من هذه القشور والزوائد. وفي ما نحن فيه أيضاً قدّم قبل الخوض في الكلام اُموراً ليس في كلّها كثير فائدة، بل بعضها يكون خالياً عن الفائدة وينبغي إلغاؤه.
الاُولى: ممّا ينبغي إسقاطه، من مقدّمات البحث، ونحن نسقطه في هذا المقام هو البحث المذكور في الكفاية عن مرادهم من «الواحد». وتمام مراده في هذه المقدّمة إثبات أنّ المراد بالواحد ليس الواحد الشخصي بل ما هو أعمّ منه ومن الكلّي؛ لأنّه كما يمكن تعلّق الأمر بالواحد الشخصي لأجل عنوان وتعلّق النهي به أيضاً بعنوان آخر، كذلك يمكن تعلّقهما بالواحد الكلي. ومثّل له بالصلاة في المغصوب، فإنّها كلّي مقول على كثيرين، فيتعلّق الأمر بها من جهة تعنونها بعنوان الصلاتية والنهي من جهة تعنونها بعنوان الغصبية.((1))
ولا يخفى ما في هذا الكلام، فإنّ ما هو منشأ الآثار وملاك الاستحالة والامتناع عند القائل به هو اتّحاد العنوانين وجوداً وفي عالم الخارج لا مفهوماً، فلا مانع من تعلّق الأمر والنهي بالكلّي من جهة واحدة أيضاً؛ لأنّه ليس موجوداً ولا يوجد في الخارج، فالاجتماع
ص: 257
فيها ليس حقيقياً فلا يدخل في نزاع النفي والإثبات. بخلاف الواحد الشخصي، فإنّ تعلّق الأمر والنهي به - حيث إنّه يوجد في الخارج - محال وممتنع، كما لا يخفى.((1))
الثانية: الأمر الثاني من الاُمور الّتي ذكرها المحقّق الخراساني(رحمه الله)،((2)) وينبغي تأجيلها إلى تنبيهات البحث لا ذكرها في المقدّمة.
الثالثة: البحث عن كون المسألة من المسائل الاُصولية، أو المبادئ الأحكامية، أو التصديقية، أو من المسائل الكلامية.((3)) وحيث إنّا قد استقصينا الكلام في ما هو الملاك لاُصولية المسألة وموضوع علم الاُصول، فلا مجال بعد المراجعة إلى ما ذكرناه للقول باُصولية هذه المسألة بل الصحيح عدّها من المبادئ الأحكامية.
الرابعة: وهي أيضاً غير محتاجه إلى البيان، وقد ذكرها في الكفاية بأنّ المسألة عقلية.((4))
لأنّا نبحث فيما هو المقصود من أنّه هل يجوز أمر المولى بحيثية لها فرد يكون منطبقاً لحيثية اُخرى مزجوراً عنها أو لايجوز؟ - على ما فصّلناه في بداية البحث - سواء كان الأمر والنهي والإيجاب والتحريم بدلالة العقل أو اللفظ.
ص: 258
الخامسة:((1)) عدم اعتبار وجود المندوحة وعدمها في النزاع((2)) وهذا أيضاً واضح؛ لأنّ ما هو المهمّ في المقام لزوم المحال واجتماع الحكمين المتضادّين وعدم لزومه، ولا يتفاوت هذا بوجود المندوحة وعدمها وإن كان القائل بالجواز لابدّ وأن يقيّده بوجودها حتى لا يلزم محذور التكليف بالمحال.
السادسة: ردّ في الكفاية ابتناء النزاع على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع.((3))
ولا يخفى فساده؛ لأنّه لو قلنا بعدم ابتنائه على ذلك ومجيء النزاع ولو كان متعلّقها الأفراد يلزم تعلّق الحكمين بواحد شخصي على القول بالجواز، ووحدة الإضافات الزجرية والبعثية؛ وذلك لأنّ المفروض وحدة الباعث والزاجر وكذا المكلّف في الأمر والنهي وأيضاً المزجور عنه والمأمور به، فيلزم منه وحدة تلك الإضافات.
لا يقال: إذا ارتفع غائلة الامتناع بتعدّد الوجه والعنوان على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع، يرتفع أيضاً لو قلنا بتعلّقها بالأفراد؛ فكما أنّه يمكن أن يكون وجود واحد مأموراً به من جهة انطباق الطبيعة المأمور بها عليه ويكون منهيّاً عنه من جهة انطباق الطبيعة المنهيّ عنها عليه ولا يضرّ ذلك بتعدّد الطبيعتين، كذلك لا مانع من تعدّد الفردين واتّحادهما في الخارج يكون فرداً للمأمور به وبعينه فرداً للمنهيّ عنه، فيجري فيه النزاع أيضاً.
فإنّه يقال: قد مرّ فيما سبق أنّ معنى تعلّق الحكم بالفرد تعلّقه به بخصوصياته، ومع ذلك لا يعقل جواز تعلّق الأمر والنهي بالفرد في مرتبة واحدة.
والقول بأنّ هذا ممكن من جهة كون الفرد فرداً ومصداقاً للطبيعة المأمور بها وفرداً للطبيعة المنهيّ عنها.
ص: 259
مندفع بأنّه خارج عمّا نحن فيه؛ لأنّ الحكم بكون الفرد فرداً للطبيعة المأمور بها من جهة اشتماله على الطبيعة وكذلك في جانب النهي، اعتراف بتعلّق الأمر والنهي بالطبيعة لا بالفرد.
السابعة: ما ذكره(قدس سره) من لزوم أن يكون لکلّ واحد من متعلّقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه.((1))
وليس له مساس بمحلّ النزاع؛ فإنّ النزاع واقع في إمكان تعلّق الأمر بحيثية وتعلّق النهي بحيثية كانت النسبة بينهما عموماً من وجه، فالقائل بالجواز يقول بالإمكان عقلاً، وقع ذلك في الخارج أم لا، والقائل بالامتناع يقول بعدم الإمكان كذلك عقلاً، وأنّه لابدّ وأن تكون النسبة بين الحيثيتين التباين.
فالأولى ذكره في ثمرة النزاع بأنّ الثمرة تظهر فيما إذا كان إيجاب وتحريم كذلك، وكان في کلّ من متعلّقهما مناط حكمه مطلقاً حتى في مورد التصادق، ففي هاهنا يقول القائل بالجواز بكون المورد محكوماً بحكمين، والقائل بالامتناع يقول بكونه محكوماً بأقوى المناطين، أو بحكم آخر غيرهما إذا لم يكن أحدهما أقوى.
فالأولى ذكر الأمر الثامن وكذلك الأمر التاسع والعاشر بعد البحث عن أصل المسألة وتحقيق الحقّ فيها.
إذا عرفت ذلك كلّه، فندخل في أصل البحث بعون الله تعالى.
إعلم: أنّه ادّعي شهرة القول بالامتناع بين القدماء، ولكنّ الحقّ عدمها. بل يمكن
ص: 260
دعوى عدم توجّه جلّ المتقدّمين لولا الكلّ بهذه المسألة،((1)) وإنّما ذهب إلى القول بالامتناع جماعة من المتأخّرين، واختار الجواز جماعة من محقّقيهم.
وعمدة ما استند إليه القائل بالامتناع: لزوم اجتماع الضدّين، وبيانه: أنّه لو قلنا بجواز توجّه الأمر والنهي بحيثيتين يكون بينهما عموم من وجه يلزم اجتماع الضدّين في محلّ واحد وهما الوجوب والحرمة.
واُجيب: بأنّه لا يلزم من ذلك اجتماع الضدّين في محلّ واحد؛ لأنّ الوجوب متعلّق بذلك الفرد لكن لم يتعلق في الحقيقة إلّا بالحيثية الّتي بها يصدق عليه أنّه صلاة مثلاً، والحرمة تعرض لذلك الفرد ولكن عرضت على الحيثية الّتي بها يصدق عليه أنّه غصب، فكلّما يكون متبعّضاً في نظر الحس أو العقل فلا مانع من كون کلّ واحد من أبعاضه معروضاً لعرض يكون هذا العرض ضدّاً لما يعرض بعضه الآخر.
واستشكل عليه: بأنّ هذا يتمّ على القول بأصالة الماهية، وأمّا على القول بأصالة الوجود فلا يتمّ هذا الجواب، لأنّ الوجود بسيط بحسب الذهن والخارج.
ثانيتها: أنّ متعلّق الأحكام لا يكون إلّا حقائق الأشياء، فمتعلّق أمر الصلاة مثلاً لا يكون إلّا حقيقة الصلاة وهي الصلاة الّتي توجد في الخارج ويأتي المكلّف بها وهو فاعلها وجاعلها، لا ما هو اسم الصلاة، ولا عنوانها المنتزع من المتعلّق بحيث لولا انتزاعه تصوّراً واختراعه ذهناً لما كان في الخارج بحذائه شيء.
ثالثتها: أنّ تعدّد الوجه والعنوان لا يوجب تعدّد المعنون؛ فإنّ المفاهيم الكثيرة والعناوين المتعدّدة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الّذي لا كثرة فيه، فلا يصحّ أن يقال: إنّ الأمر يتعلّق بجهة صلاتية الفعل والنهي بجهة غصبيته؛ لأنّ الجهات الكثيرة لا تصير سبباً لانقلاب الفعل عمّا هو عليه من الوحدة.
(ولا يخفى أنّ الأولى ذكر هذه المقدّمة في ضمن المقدّمة الثانية دفعاً للدخل وجواباً عمّا يقال: من أنّ تعدّد الوجه والعنوان موجب لتعدّد المعنون والمتعلّق الحقيقي للأحكام).
رابعتها: أنّ الوجود إذا كان واحداً تكون الماهية مثله واحدة، فمع وحدة الوجود لا يمكن تعدّد الماهية، فلا تكون للمفاهيم الصادقة على وجود واحد ماهيات وحقائق متعدّدة.
وبالجملة: فما هو الواحد وجوداً واحد ماهية وحقيقة، فالمجمع وإن كان يصدق عليه متعلّق الأمر والنهي إلّا أنّه كما يكون واحداً وجوداً يكون واحداً ماهية وحقيقة. ولا يتفاوت في ذلك القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية كما زعمه صاحب الفصول(قدس سره)،((1)) فإنّه زعم صحّة القول بالامتناع لو قلنا بأصالة الوجود؛ لأنّ المجمع يكون على هذا واحداً ولايمكن اجتماع الوجوب والحرمة فيه، وأمّا على القول بأصالة الماهية، فلا؛ لأنّه لا مانع من أن تكون لوجود واحد ماهيّات متعدّدة، هذا ما أفاده في الكفاية.
وإذا عرفت ما مهّده من المقدّمات في تحكيم مباني الاستدلال، عرفت مراده أيضاً
ص: 262
في مقام الاستدلال من أنّ المجمع إذا كان واحداً وجوداً وذاتاً يكون تعلّق الأمر والنهي به محالاً ولو كان بعنوانين.
وبالجملة: حيث نتأمّل في أدلّة القائلين بالجواز نرى أنّ كلّهم يطلبون طريق الخلاص من اجتماع الضدّين الواقع في المقام بسبب تعدّد مركب الحكمين (الوجوب والحرمة)؛ فإنّهم يستدلّون:((1))
تارة: بأنّ ماهو المتعلّق للأحكام ليس إلّا الطبائع، فلا يكون الفرد مجمعاً وموضوعاً للوجوب والحرمة ومركباً للأمر والنهي حتى يقع اجتماع الضدّين.
وتارة اُخرى: بأنّ متعلّق الأحكام وإن كان حقيقةً هو الفعل الصادر عن المكلّف ولكنّ العقل يرى بالدقّة أنّ مركب الأمر حيثيةٌ ومركب النهي حيثيةٌ اُخرى من الفعل مع وحدته، كالماء الموجود في الحوض فإنّه لا مانع من أن يكون جانباً منه ملوَّناً بلون غير ما تلوّن به طرفه الآخر.
وثالثة: بأنّه لا مانع من أن تكون لموجود واحد ماهيّتان تكون إحداهما متعلّقاً للأمر والاُخرى للنهي بناءً على صحّة القول بأصالة الماهية، فعلى هذا القول لا مانع من الجواز.
فأراد المحقّق الخراساني(رحمه الله) بما مهّد من المقدّمات ردّ هذه الاستدلالات، فالمقدّمة الثانية لردّ الدليل الأوّل؛ وأفاد الثالثة لردّ الدليل الثاني؛ والرابعة لردّ الدليل الثالث.
والتحقيق في مقام الجواب عمّا أفاده المحقّق الخراساني(رحمه الله): إنكار تضادّ الأحكام الخمسة مطلقاً.
وتوضيح ذلك: أنّ الأمر كما مرّ مراراً هو البعث، والنهي عبارة عن الزجر، وهما
ص: 263
عرضان قائمان بنفس المولى قياماً صدورياً فمعروضهما نفس المولى ولكلّ منهما إضافة وتعلّق إلى العبد وإضافة إلى الفعل من دون لزوم أن يكون العبد والفعل موجودين في الخارج، نظير تعلّق الإرادة بالمراد والعلم بالمعلوم والحال أنّ ذاتهما غير موجودين في الخارج، وإنّما هذه الإضافة تكون منشأً لانتزاع مفهوم المأمور وحمله على العبد، وإضافة الأمر إلى الفعل يكون منشأً لانتزاع مفهوم الواجب والمأمور به وحمله على الفعل، فيقال: إنّه واجب ومأمور به أو حرام ومنهيّ عنه، ولكن ليس معنى ذلك أنّ الوجوب أو الحرمة عرض معروضه فعل المكلّف حتى لا يمكن اجتماعهما في معروض واحد؛ لأنّ لازم ذلك إمكان تحقّق العرض بدون المعروض في صورة العصيان، لأنّ في صورة العصيان ليس فعلاً حتى يعرضه الوجوب ويضاف إليه الأمر حقيقةً والحال أنّ البعث متحقّق بالنسبة إلى العصاة.((1))
لا يقال: إنّ مناط صدق المحمول على الموضوع كون الموضوع معروضاً له والمحمول عرضاً له، فلابدّ من وجود الموضوع حتى يعرضه المحمول.
لأنّه يقال: ليس الأمر كذلك، ولا يكون مناط الصدق في القضايا كون المحمول عرضاً للموضوع، ولا ملازمة بين صدق المحمول عليه وكونه عرضاً له، فملاك صدق المحمول على الموضوع في قضية: «هذا الفعل واجب» أو «هذا العبد مأمور» ليس إلّا وجود منشأ الانتزاع وهو الأمر، فوجود الأمر وعروضه بنفس المولى يكون هو المناط لانتزاع مفهوم الواجب وملاك صدقه على الفعل.
إذا عرفت ذلك تعرف أنّ إمكان انتزاع ذلك المفهوم وصدق حمله على الفعل وامتناعه إنّما يكون دائراً مدار إمكان الأمر وامتناعه، وفي ما نحن فيه لا يأبى العقل
ص: 264
ولا يرى امتناعاً لأمر المولى عبده بحيثية يمكن أن يجمع العبد بينها وبين الحيثية المزجور عنها بسوء اختياره. ولا يلزم منه اجتماع العرضين في موضوع واحد.
إن قلت: إنّ إطلاق الأمر والنهي يقتضي تعلّقهما بالفرد الّذي يكون مجمعاً للعنوانين، ولازم ذلك عروض العرضين المتضادّين على نفس المولى بسبب قيام الأمر والنهي بنفسه قياماً صدورياً.
قلت: ليس معنى إطلاق الأمر انحلاله إلى الأفراد، بل المراد من إطلاقه كون متعلّقه حيثية طبيعة المأمور به من دون قيد زائد فيها، ومعناه سقوط الأمر بإتيان کلّ فردٍ من الأفراد. وكذلك الإطلاق في جانب النهي.
لا يقال: إنّ لازم بعث المولى بحيثية يمكن أن يجمع المكلّف بينها وبين الحيثية المنهي عنها اجتماع الضدّين أي الوجوب والحرمة في محل واحد وهو مجمع الحيثيّتين.
لأنّه يقال: لا يكون الوجوب والحرمة عرضاً حتى يقال بعدم إمكان عروضهما معاً على فعل المكلّف، وإلّا فيجب أن لا يتعلّق الوجوب بالفعل إلّا بعد وجوده حتى لا يلزم وجود العرض بدون المعروض. فالوجوب والحرمة و مفهوم الواجب والحرام مفاهيم تنتزع من بعث المولى وزجره وإضافتهما إلى الفعل. وليس مناط صدق حمل الواجب أو الحرام على الفعل عروض هذه الإضافة؛ لأنّه لم يوجد بعد، بل ملاك صدقه كما ذكر ليس إلّا العرض القائم بنفس المولى قياماً صدورياً.
فلا يصحّ أن يقال: إنّ بعث المولى وزجره على هذا يصير سبباً لاجتماع الضدّين؛ لأنّه يقال: إنّ المولى لم يبعث إلّا بالحيثية الصلاتية بحيث يكون وجود طبيعة الصلاة تمام متعلّق أمره، فلو كانت الصلاة ملازمةً لتحليل الغذاء أو تليين الأعضاء مثلاً، لا يقال: إنّه بعث إلى تحليل الغذاء؛ لأنّ تمام متعلّق بعثه ليس إلّا وجود طبيعة الصلاة تكون ملازمة لشيء أم لم تكن. وهكذا الكلام في جانب الغصب والتصرّف في مال الغي
ص: 265
ومرجع جميع ما ذكرناه ليس إلّا عدم كون الوجوب أو الحرمة عرضاً لفعل المكلّف. وحيث إنّ غير واحد من القائلين بالجواز اعترفوا بكونهما عرضاً له صرفوا تمام همّهم في مقام الجواب لإثبات تعدّد معروضهما ولم يأتوا بما يكفي في مقام الجواب، فتدبّر.
تمثيل: كما يمكن أن يكون شيء واحد متعلّقاً للعلم والجهل في آن واحد مثلاً: علمت بمجيء عادل في الغد مع جهلك بمجيء العالم فيه، فاتّفق مجيء زيد العالم العادل، يكون ذلك المجيء معلوماً ومجهولاً أي منطبقاً لکلا العنوانين ومصداقاً لهما، ولا يقول أحد بوقوع اجتماع الضدّين في هذا المثال، كذلك لا مانع من كون وجود واحد منطبقاً ومصداقاً لعنوان المأمور به والمنهيّ عنه من غير أن يتحقّق اجتماع الضدّين.
إن قلت: إنّ العلم والجهل قد تعلّقا في المثال بالماهية، وهذا بخلاف المقام لأنّ البعث والزجر يتعلّقان بالوجود.
قلت: إنّ العلم والجهل أيضاً متعلّقان بالوجود، لأنّ العلم متعلّق بوجود مجيء العادل والجهل بوجود مجيء العالم.
هذا تمام الكلام في إبطال ما توهّم أن يكون دليلاً على الامتناع.
وأمّا القول بالجواز، فالقائل به غنيّ عن الاستدلال بعدما حقّقناه في المقام؛ لأنّه إذا لم يثبت الامتناع يتّجه القول بالجواز، إذ لا يتصوّر ثالث لهما.
ولا يعتنى بما قد يقال: من أنّ عدم إثبات الامتناع ليس دليلاً على الجواز، فإنّ من الممكن أن يكون الأمر بهذه الحيثية الّتي يمكن أن يجمع العبد بينها وبين الحيثية المزجور عنها من الممتنعات ولكن لم نعثر على وجه الامتناع.
لأنّا نحكم بالجواز أو الامتناع بحسب ما تدرك عقولنا. ولو سلّمنا ذلك فلا مانع من شمول إطلاق الأمر والنهي للفرد الّذي يكون مجمعاً للحيثيّتين.
ص: 266
ومع ذلك كلّه، فيمكن أن يستدلّ للقول بالجواز بأنّا نرى أنّ المولى إذا أمر عبده بفعل كخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاصّ((1)) وجعل لذلك الفعل ثواباً ولعدم انتهائه عن هذا النهي عقاباً فخاط العبد في هذا المكان، فلو طالبه بالثواب الموعود على الخياطة لا يصحّ للمولى أن يقول: إنّك غير مستحقّ للثواب لوقوع الخياطة في هذا المكان. والعرف يعتبر هذا المولى مجازفاً في أقواله، كما أنّ العقل أيضاً يراه مجازفاً؛ لأنّ العبد قد أتى بتمام متعلّق الأمر وإن أتى بتمام متعلّق نهيه أيضاً.
بقي في المقام شيء وهو أنّ ثمرة النزاع إنّما تظهر فيما إذا كان قصد التقرّب شرطاً لصحّة المأمور به وأتى المكلّف به ولكن في ضمن فرد يكون مجمعاً للحيثيّتين، فلو قلنا بأنّ الفعل الّذي يكون مصداقاً للحيثية المزجور عنها غير قابل لأن يتقرّب به ولا يصلح لأن يتعبّد به، لا يعدّ الإتيان بهذا الفرد المنطبق للعنوانين والمجمع للحيثيّتين إطاعة وامتثالاً؛ لأنّه لم يأت بما هو المأمور به فلا يكون ممتثلاً سواء قلنا بالجواز أو الامتناع؛ لأنّ المفروض اعتبار قصد القربة ودخله في انطباق عنوان المأمور به على الفعل، وذلك كالصلاة والصوم. فلو فرض عدم صلاحية الفعل لأن يتقرّب به لا يكون ذلك الفعل فرداً للمأمور به ومنطبقاً لعنوانه أصلاً.
وأظنّ أنّ المشهور من المتقدّمين حيث حكموا ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة أو الوضوء بماء مغصوب حكموا به لهذه الجهة، ولم يتفطّن القائل بالامتناع بمنشأ فتواهم
ص: 267
فتوهّم أنّ ذلك لجهة أنّهم يعدّون محل النزاع من صغريات الكلّية المذكورة، فادّعى - بناءً على هذا التوهّم الفاسد - الشهرة على الامتناع.((1))
وأمّا لو قلنا: إنّ الفعل الّذي يكون منطبقاً ومصداقاً للحيثية المزجور عنها لا يخرج بذلك عن كونه صالحاً لأن يقصد التقرّب به ولا فرق بينه وبين غيره في كونه صالحاً لأن يتقرّب به، يصير من صغريات مسألتنا هذه، وتظهر الثمرة بناءً على هذا الفرض. هذا ملخّص الكلام في المقام. وعلى الله التوكّل وبه الاعتصام.
ينبغي التنبيه على اُمور:
التنبيه الأوّل: جريان النزاع في العموم من وجه والمطلق
لا فرق فيما ذهبنا إليه من جواز الأمر بحيثية يمكن اجتماعها مع الحيثية المزجور عنها أن تكون النسبة بين الحيثيّتين العموم من وجه أو المطلق، فلا مانع من توجيه الأمر إلى عامّ وتوجيه النهي إلى حيثية تكون بالنسبة إليه خاصّاً. ولا يلزم من جمع العبد بين
ص: 268
الحيثيتين بسوء اختياره توجّه أمر المولى ونهيه إلى وجود مركّب واحد؛ لأنّ ذلك صحيح لو قلنا بانحلال الأمر إلى الأوامر المتعدّدة بحيث يكون كلّ حيثية خاصّة موجودة مع حيثية اُخرى بهذا القيد مأموراً بها، ولكن لا نقول بهذا، بل نقول: إنّ ما هو تمام متعلّق أمر المولى لا يكون إلّا تلك الحيثية وأمره متعلّق بإيجاد تلك الحيثية الحسنة الّتي لا تكون فيها جهة قبح أصلاً، فلو جمع العبد بين هذه الحيثية والحيثية المقبحة الّتي لا تكون فيها جهة حسن أصلاً لا يصير هذا سبباً لامتناع توجه الأمر بهذه الحيثية والنهي بالحيثية الاُخرى ولو كان الفعل المتحيّث بالحيثيّتين ذا مصلحة ومفسدة.
نعم، لو كانت مصلحة الحيثية المحسّنة أقوى من مفسدة الحيثية المقبّحة لكان الفعل حسناً باعتبار ذلك، كما أنّه بالعكس لو كان الأمر بالعكس.
ولكن في صورة أقوائية المصلحة لو فرض وجود المندوحة لا يكون صدوره عن المكلّف حسناً ولذا لا يمكن التعبّد به ولا يصلح لأن يتقرّب به، أمكن أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر كما ذكرناه أو لا يمكن، كما اختاره في الكفاية.
ولا يخفى: أنّه على القول بالامتناع لا مجال للقول بتقييد جانب النهي وترجيح جانب الأمر في صورة أقوائية المصلحة مع وجود المندوحة؛ لأنّ معنى هذا ليس إلّا حرمة الغصب أو التصرّف في مال الغير إلّا في حال الصلاة ولم يقل به أحد، ففي جميع الموارد على الامتناع لابدّ من تقييد جانب الأمر إلّا في صورة عدم المندوحة وأقوائية مصلحة الأمر، هذا.
والحاصل: أنّ اجتماع الأمر والنهي الّذي يكون تكليفاً محالاً إنّما يكون من جهة امتناع حصول الحالة الزجرية والبعثية في نفس المولى بالنسبة إلى شيء واحد في زمان واحد كما مرّ ذكره، ولا يكون هذا إلّا إذا كانت الحيثيتان متساويتين في الصدق أو متلازمتين في الوجود كالاستدبار والاستقبال، أو تكون الحيثية المزجور عنها أعمّ من
ص: 269
الحيثية المأمور بها في الصدق أو في الوجود، وأمّا إذا لم تكن النسبة بينهما كذلك فلا إشكال ولا امتناع حتى إذا كانت النسبة بينهما عموماً مطلقاً مثل الأمر بحيثية والنهي عنها إذا كانت مخصّصة بخصوصية خاصّة بحيث لا تكون تلك الخصوصية بنفسها تمام متعلّق النهي ولا الحيثية مخصّصة بها، بل كان لکلّ منهما دخل في حصول الغرض.
التنبيه الثاني: جريان النزاع في الأمر الندبي والنهي التنزيهي
لا يخفى عليك: أنّ ما ذكرناه من امتناع اجتماع الأمر الوجوبي والنهي التحريمي إذا كان متعلّقاهما متساويين في الصدق أو في الوجود، أو كانت الحيثية المأمور بها أخصّ من الحيثية المزجور عنها، وجواز الاجتماع في سائر الموارد؛ يكون جارياً أيضاً فيما إذا لم يكن الأمر وجوبياً بل يكون ندبياً والنهي تحريمياً، أو كان الأمر ندبياً والنهي تنزيهياً،((1)) ولكن الفرق أنّ في الصورة الأخيرة لو كان متعلّق الأمر عبادياً لا مانع من صحّة وقوعه عبادة لو أتى به في ضمن الفرد المتحيّث بالحيثية المتعلّقة للنهي التنزيهي؛ فإنّ صدوره عن الفاعل لا يكون قبيحاً فلا مانع من التقرّب به كما إذا كانت الحيثيتان المتعلّقتان للأمر الندبي والنهي التنزيهي متساويتين وكان ملاك النهي أقوى، فالحيثية المأمور بها وإن لم يتعلّق بها الأمر لكن لا مانع من وقوعها صحيحة وعبادة لو قلنا بكفاية قصد الملاك.
التنبيه الثالث: في وقوع الاجتماع في بعض العبادات
ممّا استدلّ به القائل بالجواز وقوع الاجتماع في موارد كثيرة مثل العبادات المكروهة كصوم يوم عاشوراء، والصلاة في الحمّام، وفي مواضع التهمة، والصيام في السفر،
ص: 270
وبعد وقوع الاجتماع لا مجال للنزاع في إمكانه وامتناعه؛ لأنّ الوقوع أخصّ من الإمكان فلو لم يجز الاجتماع لما وقع في الموارد المذكورة.((1))
لا يقال: إنّ ملاك الامتناع موجود إذا كان النهي تحريمياً والأمر وجوبياً، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا مانع من الاجتماع لعدم تحقّق ملاك الامتناع.
لأنّه يقال: لا فرق فيما هو ملاك الاستحالة والامتناع وملاك الجواز والاجتماع بين اجتماع النهي التحريمي مع الأمر الوجوبي، والنهي التنزيهي مع الأمر الوجوبي أو الندبي، كما مرّ بيانه في التنبيه الثاني.
ويمكن دفع أصل الإشكال على سبيل الإجمال في جميع الموارد.
أوّلاً: بما أفاده في الكفاية بناءً على ما اختاره من الامتناع وهو: أنّ بعد قيام البرهان على استحالة الاجتماع لا مجال للأخذ بما يكون ظاهره الاجتماع، فلابدّ لنا من التأويل والتوجيه.((2))
وثانياً: نقول بأنّ في جميع الموارد الّتي توهّم الاجتماع في الشرعيات لا يدلّ الدليل على أزيد من صحّة العبادة، فليس لنا أن نقول بأنّ ما هو المتعلّق للنهي في هذه الموارد متعلّق للأمر أيضاً بعد عدم وجدان الدليل على كونه مأموراً به.
وأمّا صحّة الفعل ووقوعه عبادة فيمكن أن يكون لأجل الملاك والمحبوبية الذاتية. هذا ما يمكن أن يقال في الجواب على نحو الإجمال.
وأمّا الجواب على سبيل التفصيل، فنقول: إنّ بعض الموارد الّتي ذكرها بعض من القائلين بالجواز في هذا الدليل داخل في حريم النزاع، كما إذا تعلّق الأمر بحيثية والنهي
ص: 271
التنزيهي بحيثية اُخرى وكانت النسبة بينهما عموماً من وجه كالصلاة في مواضع التهمة،((1)) فإنّ الأمر قد تعلّق بحيثية الصلاة والنهي بحيثية الكون في موضع التهمة، جمع المكلّف بين الحيثيتين أم لا؛ ومثل ما إذا أمر بحيثية على نحو الإطلاق ونهى تنزيهاً عن هذه الحيثية إذا كانت مخصّصة بخصوصية بحيث يصير متعلّق النهي خاصّاً بالنسبة إلى الأمر كالصلاة في الحمّام.((2)) فإذا كان من هذا القبيل يبتني الأمر على أصل المسألة ويكون داخلاً في محلّ النزاع، والقائل بالجواز في فسحة من جهة ذلك، وعلى القائل بالامتناع جواب الإشكال.
وأمّا إذا تعلّق النهي بما ليس له بدل - كصوم يوم عاشوراء((3)) - فاللازم على کلّ من القائل بالجواز والامتناع التخلّص عن الإشكال؛ لأنّه وارد على کلّ حال.
و ملخّص ما أفاده المحقّق الخراساني(قدس سره) هو: الالتزام بوجود مصلحة في الفعل من غير أن تشوبها مفسدة، ووجود مصلحة في الترك من جهة انطباق عنوان ذي مصلحة عليه، أو من جهة ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة من دون الانطباق، فهما يكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين اللذين أمر المولى بأحدهما من جهة أرجحيّته، فلو أتى المكلّف بالآخر لا مانع من صحّته لوجود المصلحة فيه.((4))
ص: 272
وفيه أوّلاً: مبنائية جوابه وتوقّفه على ما اختاره في معنى النهي من أنّه طلب ترك الوجود، وقد عرفت فساده وأنّ الظاهر منه هو الزجر عن الفعل.
وثانياً: سلّمنا مبناه لكن الظاهر تعلّق النهي بنفس الترك، لا العنوان المنطبق على الترك أو الملازم له.
وثالثاً: العنوان المنطبق على الترك يكون عدمياً لا محالة، لأنّ الترك عدميّ فلا داعي لتبديل متعلّق النهي من الترك إلى العنوان المنطبق عليه، لأنّه يمكن تصوير المصلحة في الترك أيضاً.
ورابعاً: ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة بغير الانطباق ليست تحت يد المكلّف حتى يتعلّق النهي بها.
التنبيه الرابع: لا يخفى أنّ المحقّق الخراساني(قدس سره) قد اختصّ التنبيه الأوّل من تنبيهات الباب بذكر مسألة: من توسّط داراً مغصوبة وانحصر التخلّص عن الغصب بالخروج عنها، فهل يكون هذا الخروج كالدخول حراماً أو لا؟
وقد أفاد في أوّل هذا التنبيه ما ليس راجعاً إلى أصل المطلب وهو: أنّ الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثّراً فيه كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام إلّا أنّه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدّي إليه لا محالة، فإنّ الخطاب بالزجر عنه حينئذٍ وإن كان ساقطاً إلّا أنه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه وعصياناً لذلك الخطاب ومستحقّاً عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب، وهذا ممّا لا شبهة فيه ولا ارتياب.
وفيه: أنّ الاضطرار إلى فعل الحرام الّذي فيه ملاك الوجوب ولكن كان ملاك الحرمة فيه أقوى لا يوجب تعلّق الوجوب به؛ لأنّ الاضطرار يرفع النهي والحرمة المتعلّقة إلى الفعل لا المفسدة الكامنة فيه، فلا يعقل تعلّق الوجوب بفعل فيه مفسدة
ص: 273
أقوى من مصلحته وإن لم يتعلّق به النهي من جهة. نعم، لو فرض حصول المصلحة في ظرف الاضطرار وكانت أقوى من مفسدة الترك لا مانع من وجوب الفعل.
فالاضطرار إلى شرب الخمر مثلاً لا يصير موجباً لوجوبه وإن كان فيه منافع للناس. نعم، ربما يجب ذلك لوجود مصلحة أقوى من المفسدة في ظرف الاضطرار كما إذا اضطرّ بشربه لانحصار طريق حفظ النفس به.
وبعبارة اُخرى: قد ذكر المحقّق الخراساني(قدس سره) في مقدّمة التنبيه الأوّل الّذي اختص لبيان حكم هذه المسألة اُموراً ثلاثة:
أحدها: ارتفاع الحرمة والعقوبة فيما إذا اضطرّ المكلّف إلى ارتكاب الحرام.
ولا يخفى: أنّ الاضطرار الّذي ذكره، تارة: يكون عقلياً كما إذا اضطرّ إلى ارتكاب حرام على نحو لا يكون له اختيار في تركه، كما إذا حبس في مكان مغصوب، فالعقل حاكم بارتفاع حرمة الكون في هذا المكان والعقوبة عليه.
واُخرى: يكون عرفياً كما إذا اضطرّ إلى شرب الخمر من جهة انحصار علاج مرضه به، فهذا الاضطرار لا يكون عقلياً؛ لأنّه مختار في شرب الخمر. وفي هذا القسم أيضاً ترتفع الحرمة والعقوبة لكن بحديث الرفع.
وثالثة: يكون شرعياً كما إذا اضطرّ إلى أداء الصلاة في المكان الغصبي، فإنّ اضطراره بالتصرّف في مال الغير يكون لأجل حكم الشارع بوجوب أداء الصلاة.
وثانيها: أنّ الاضطرار إلى الحرام مضافاً إلى أنّه يصير موجباً لارتفاع الحرمة والعقوبة عليه يكون موجباً لتأثير ملاك الوجوب لو كان في الفعل کلّ من الملاكين، ملاك الحرمة وملاك الوجوب، ولكن كان ملاك الحرمة أقوى. فلو فرض عدم تأثير ملاك الحرمة فلا مانع من تأثير ملاك الوجوب.
وفيه: أنّه بالاضطرار يرتفع النهي والحرمة المتعلّقة بالفعل لا المفسدة الكامنة فيه،
ص: 274
فما دام المفسدة موجودة فيه لا يصحّ تعلّق الوجوب به؛ لأنّ المانع من عدم تعلّق الوجوب به وصيرورته محبوباً للمولى وجود المفسدة الكامنة فيه لا وجود النهي، فإذا اضطرّ المكلّف إلى شرب الخمر لا يجب شربه من جهة أنّ فيه منافع للناس، بل هو باقٍ على حاله.
نعم، لو حدثت في ظرف الاضطرار مصلحة أقوى في الفعل، كما إذا توقّف حفظ النفس على شرب الخمر، يصير ذلك الفعل واجباً لا محالة، لكن هذه غير المصلحة الكامنة فيه مع قطع النظر عن الاضطرار.
ولعلّ أن يكون وجه هذا التوهّم قولهم بالوجوب وتأثير ملاك الوجوب إذا اجتمع الأمر والنهي واضطرّ المكلّف إلى ارتكاب المجمع بناءً على الجواز. وهذا غير ما نحن فيه، كما لا يخفى.
وثالثها: أنّ الاضطرار إذا كان بسوء اختيار المكلّف لا يرتفع بسببه أثر الحرمة من المبغوضية والعقوبة على الفعل، كما أنّه لا يؤثّر ملاك الوجوب إن كان فيه.
والّذي ينبغي أن يقال في المقام أنّ الاضطرار إلى فعل إمّا أن يكون بغير دخل اختيار المكلّف فيه أو باختياره، وفيما إذا كان باختياره تارة: يكون سبب اضطراره فعلاً مباحاً، واُخرى فعلاً حراماً، وهذا الأخير إمّا أن لا يكون من جنس الحرام الّذي اضطرّ إليه، كما إذا ضرب شخصاً بغير حقّ مع علمه بأنّه موجب لحبسه في الدار المغصوبة، أو يكون من جنسه ولكن لا يكون شخصه كما إذا تصرّف في دار عمرو عدواناً مع علمه بأنّ هذا موجب لحبسه في دار زيد بدون إذنه، أو يكون شخصه أيضاً كما إذا اضطرّ إلى التصرّف في دار زيد عدواناً من جهة تصرّفه السابق - كدخوله في تلك الدار - عدواناً، وفي جميع هذه الموارد تارة: يكون الاضطرار إلى ارتكاب الحرام مع الالتفات بموجبية موجبه له أم لا؟ وفي صورة الالتفات إمّا يحصل له العلم
ص: 275
بحصول الاضطرار وكونه مسبّباً من هذا الفعل، أو يبقى مردّداً. هذه هي الفروض المتصوّرة لكون الاضطرار بالاختيار.
وأمّا إذا كان الاضطرار بغير الاختيار، فلا شكّ في كونه موجباً لارتفاع الحرمة والعقوبة على الفعل المضطرّ إليه.
وأمّا إذا كان سببه فعلاً اختيارياً - حراماً كان أم مباحاً - وعلم المكلّف بموجبيته للاضطرار، فالظاهر أنّه لا يرتفع بسببه أثر الحرمة من العقوبة على الفعل وغيرها وإن كان التكليف ساقطا في حقّه فعلاً. وأمّا في صورة عدم العلم وحصول الترديد في سببية الفعل للحرام المضطرّ، فالظاهر أنّه أيضاً كذلك سواء كان سببه فعلاً حراماً أو مباحاً.
إذا عرفت ذلك كلّه، فاعلم: أنّهم قد اختلفوا في أصل المسألة، فيما يكون الاضطرار بسوء الاختيار وينحصر التخلّص به، على أقوال:
أحدها: القول بوجوب التصرّفات المتوقّف عليها الخروج ليس إلّا، من دون ترتّب مفسدة وعقوبة ومؤاخذة عليها، فهذه التصرّفات واجبة ومأمور بها رأساً ومن الأوّل. وهذا مختار الشيخ(قدس سره).((1))
ثانيها: القول بوجوبها وحرمتها معاً. وهو مختار صاحب القوانين.((2))
ثالثها: القول بكونها منهيّاً عنها بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار.((3))
رابعها: القول بوجوبها مع كونها مخالفة ومعصية للنهي السابق. وهو مختار صاحب الفصول(رحمه الله).((4))
ص: 276
ولا يخفى ما في مختار صاحب الفصول(قدس سره) من الفساد؛ لأنّه لا يعقل مخالفة النهي السابق الساقط في حال سقوطه؛ لأنّ المخالفة فرع بقاء الأمر.
وأمّا وجه مختار الشيخ(قدس سره) فهو: أنّ التصرّفات المتوقّف عليها الخروج قبل الدخول لاتكون مقدورة فلا يمكن تعلّق الأمر والنهي بها مطلقاً بل تصير مقدورة بعد الدخول، فالتكليف المتعلّق بها - أمراً كان أو نهياً، مشروطاً كان أم مطلقاً - لا يتعلّق بها إلّا بعد الدخول، وحيث إنّه لا يمكن في ذلك الظرف تعلّق النهي بتلك التصرّفات لأنّه مضطرّ إليها، فلابدّ وأن يتعلّق الأمر بها في ذلك الظرف مقدّمة للخروج، ولا يعقل أن يكون التكليف غير ذلك.
وبعبارة اُخرى: التصرّفات الخروجية لا تكون منهيّاً عنها أصلاً. والتكليف المتوجّه إليها ليس إلّا وجوبياً راجعاً إلى الخروج، ويكون هذا التكليف قبل الدخول مشروطاً وبعده مطلقاً. والسرّ في ذلك: أنّ التصرّفات المذكورة قبل الدخول لا تكون مقدورة فلا يتعلّق بها تكليف مطلق، وبعد الدخول تصير مقدورة، ولكن حيث لا يعقل توجّه النهي إليها لرجوعه إلى وجوب إبقاء الغصب مثلاً، فيتوجّه إليها الأمر بالخروج لا محالة.
وهذا نظير ارتكاب فعلٍ يؤدّي إلى مرض يكون علاجه منحصراً في شرب الخمر؛((1)) فإنّه لا يصحّ تعلّق النهي بشرب الخمر في هذا الظرف قبل ارتكاب الفعل المذكور، لأنّه تكليف بما هو خارج عن تحت الاختيار، ولكن يتوجّه الأمر بشرب الخمر في هذا الظرف قبل ارتكابه مشروطاً بارتكاب الفعل المزبور، ومطلقاً بعد الارتكاب، هذا.
ولكن مع ذلك كلّه، المسألة غير خالية عن الإشكال، لأنّه لو قيل بمقالة صاحب
ص: 277
الفصول(رحمه الله) يلزم اجتماع الضدّين. ولو قيل بحرمة التصرّفات المتوقّف عليها الخروج، فهو خلاف الوجدان. كما أنّ الأمر كذلك لو قيل بوجوبها من غير الحرمة.
وربما توهّم في المقام إمكان الترتّب، أي ترتّب الأمر بالخروج على عصيان النهي عن الغصب. وهذا وإن كان بحسب الظاهر قريباً، ولكن لم ينقل من أحد من الأعلام. ولعلّ السرّ في ذلك: أنّ الترتّب في غير هذا المقام إنّما يتصوّر إذا كان لنا أمران: أحدهما متعلّق بالأهمّ والآخر بالمهمّ في ظرف عصيان الأهمّ، ولكن فيما نحن فيه ليس الأمر بالخروج مغايراً مع النهي عن الغصب؛ لأنّه قد مرّ فيما سلف أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ بمعنى اتّحاد متعلّقيهما في نفس الأمر، فالأمر بالخروج ليس إلّا الأمر بترك الغصب وهو منتزع عن النهي عن الغصب، كما أنّ النهي عن الترك منتزع من الأمر بالفعل.
وبالجملة: فالنهي عن الغصب ينحلّ إلى نواهي متعدّدة، فكل آنٍ من آنات الغصب منهيّ عنه وينتزع منه الأمر بترك الغصب، وهذا بخلاف باب الترتّب فإنّ کلّ واحد من الأمرين يكون غير الآخر.
والذي لا يبعد أن يكون أقرب الوجوه في المسألة هو: التفصيل بين من كان تائباً ونادماً من عمله وأراد الخروج لأجل التخلّص عمّا هو مبغوض للمولى، وبين من لم يكن تائباً بل كان باقياً على العصيان وعدم الاعتناء بنهي المولى، فإذا كان نادماً من عمله لا يكون عمله منهيّاً عنه ولا يعاقب على التصرّفات الخروجية؛ لأنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يصير تصرّفه هذا حسناً وممدوحاً شرعاً وعقلاً. وأمّا إذا لم يكن نادماً وتائباً، يكون عمله منهيّاً عنه بالنهي السابق الساقط، فلا مانع من أن يعاقبه المولى على التصرّفات الخروجية. والله تعالى أعلم بالصواب.
غفر الله لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
ص: 278
ص: 279
هل النهي عن الشيء يقتضي فساده أو لا؟
إعلم: أنّ الباحثين عن هذه المسألة من المتقدّمين قد أدّوا حقّها وأدركوا الجهة المبحوث عنها فيها، ومع كمال الاختصار بيّنوها في كتبهم غاية التبيين. بخلاف أكثر المتأخّرين؛ فإنّهم وإن ذكروا في المقام مطالب كثيرة إلّا أنّ أكثرها أجنبيّ عمّا يرجع إليه روح البحث وجهة الاختلاف ومحلّ الفائدة، بل ربما لم يأت بعضهم بعد هذه التطويلات بما هو راجع إلى أصل المسألة ويبيّن الحقّ به فيها، وهذا من قبيل الاختلاف في أنّ هذا البحث من مباحث علم الاُصول أو غيره من العلوم.((1)) ومن قبيل الاختلاف في كون المسألة عقلية.((2)) ومعنى الاقتضاء وغيرها.((3)) وربما صارت هذه الاختلافات حجاباً للواقع وسبباً لتبعيد المسافة للمتعلّم. ونحن بعد إلغاء تمام هذه التطويلات ندخل في البحث مبتدءاً بتعريف الصحّة والفساد بعون الله تعالى:
ص: 280
معنى الصحّة والفساد((1))
إنّ کلّ موجود إذا وجد، إمّا يوجد على نحو يترقّب وجوده وينطبق عليه عنوان ذلك الموجود المترقّب وجوده أم لا.
فإن كان تحقّقه في الخارج أو غيره من الوعاء المناسب له على نحو يكون ذلك الموجود هو الموجود المترقّب وجوده يتّصف ذلك الموجود بصفة الصحّة وتترتّب عليه آثار الوجود المعنون بعنوان الصلاة أو الصوم أو النبات أو الإنسان مثلاً، ويقال: إنّه صحيح من جهة انطباق العنوان المترقّب وجود معنونه على ذلك الموجود.
وإن لم يكن نحو تحقّقه هكذا: بل كان على نحو لا يصدق عليه ذلك العنوان ووجد على خلاف ما يترقّب أن يوجد يتّصف بالفساد. ولكن لا من جهة نفس ذاته، فإنّ ما وجد بحسب نفس ذاته تامّاً تترتّب عليه آثاره المخصوصة، بل من جهة عدم انطباق ذلك العنوان عليه، وتحققه على خلاف ما يترقّب أن يوجد.
وبالجملة: فما وجد لا يتصف بالفساد من جهة نفس ذاته ولا يكون ناقصاً من حيث ذاته؛ فإنّ القراءة قراءة و السورة سورة والتسبيح تسبيح وكذلك الركوع والسجود كلها بحسب ذاتها تامّة تترتّب عليها آثارها المخصوصة بها ولا نقص ولا فساد فيها بحسب هذا.
ولكن لا يكون هذا ملاك الصحّة كما يوهمه ما في الكفاية؛((2)) فإنّه على ما ذكرناه
ص: 281
تكون الصحّة أخصّ من التمامية الّتي هى عبارة عن منشأيّة الشيء لترتّب آثاره عليه، فربما يكون الشيء تماماً وتترتّب عليه آثاره ولا يكون صحيحاً من جهة أنّه وجد على خلاف ما يترقّب أن يوجد ولا ينطبق عليه عنوان الشيء المترقّب وجوده. ولكن لا يمكن أن يكون الشيء صحيحاً ولا يكون تماماً ولا تترتّب آثاره عليه.
وهكذا الكلام في جانب الفساد؛ فإنّه أيضاً يكون أخصّ من التمامية فربما يكون الشيء تامّاً ولا يكون فاسداً من جهة أنّه وجد على نحو ينطبق عليه عنوان الموجود المترقّب وجوده. وربما يكون الشيء تامّاً تترتّب عليه آثاره الخاصّة به ويكون فاسدا لتحقّقه على خلاف ما يترقّب أن يوجد وعدم انطباق عنوان الموجود المترقّب وجوده عليه، هذا.
ولا بأس بأن يقال بأنّ التقابل الواقع بين الصحّة والفساد قريب من تقابل العدم والملكة. ثم إنّ الموجود الّذي يوجد في الخارج أو في وعاء آخر إمّا أن يكون من الموجودات الّتي توجد تارة على نحو يترقّب وجودها، واُخرى لا على هذا النحو بل يوجد على خلاف ما يترقّب أن يوجد؛ وإمّا أن لا يكون من هذا القبيل بل يكون بحيث كلّما يتحقّق في وعائه المناسب له يترتّب عليه أثره وينطبق عليه عنوان ما يترقّب وجوده ولا ينفكّ عنه ذلك، وهذا كإتلاف مال الغير والملاقاة مع النجاسة وغيرهما، فما يكون من هذا القسم لا يتصور فيه النزاع ولا يكون محلّا للاختلاف.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ اتّصاف الأشياء بالصحّة والفساد، تارة: يكون على نحو يكون معلوماً عند الكلّ. وبعبارة اُخرى: تارة يكون الشيء بحيث كلّما وجد يعرف کلّ واحد من العقلاء بأنّه وجد على نحو يترقّب وجوده أم لا. وهذا يكون لمعلومية کلّ ما له دخل في وجود هذا الشيء على هذا النحو عندهم، ومعلومية ما ليس له هذه الدخالة.
ص: 282
واُخرى: لا يكون الشيء ممّا يعلم حاله ووجوده على هذا النحو، فلا يعرف الانطباق وترتّب الآثار إلّا من كان عالماً به. وهذا كالأدوية والمعاجين المخصوصة، فإنّ ترتّب أثر كذائيّ خاصّ على معجون الموجود الخاصّ ممّا لا يعلمه إلّا من كان عالماً بالطبّ، كما أنّ عدم ترتّب هذا الأثر عليه لا يكون معلوماً إلّا عنده. ومن هذا القبيل تكون المعاملات والعبادات والإيقاعات؛ فإنّه لا يعلم ما له دخل في ترتّب الأثر واعتبار الملكية مثلاً في البيع وغيره إلّا العالم به وهو الشارع.
فلو تعلّق النهي بما كان من قبيل القسم الأوّل يكون النهي عنه دالّا على الحرمة والمبغوضية ولا دلالة فيه على فساده أصلاً. كما لو نهى المولى عبده عن لبس الحرير والذهب أو لباس آخر، فلا يُعقل أن تكون لنهيه هذا دلالة على فساد لبس الحرير أو فساد ما يترتّب عليه من الأثر وهو الزينة.
وأمّا إذا تعلّق النهي بما كان من القسم الثاني يكون النهي المتعلّق به دالّا على الفساد وإرشاداً بعدم تماميته وترتّب الأثر المقصود عليه. وهذا كنهي الطبيب المريض بأن لا يزيد شيئاً على الدواء الخاصّ المركّب من الأجزاء الخاصّة أو لا ينقص منه شيئاً. ومثل نهي الشارع عن كثير من المعاملات، كنهيه عن بيع الغرر، وبيع المنابذة، والملامسة، وبيع الكلب، أو نهيه عن لبس الحرير في الصلاة.
ولا يخفى عليك: أنّ النهي الدالّ على الحرمة مستلزم للفساد إذا كان متعلّقه أمراً عبادياً.((1)) بل مطلق الحرمة والمبغوضية، سواء كان دليلهما لفظياً أو لبّياً، مستلزمة لفساد المحرم والمبغوض إذا كان المحرم أمراً عبادياً؛ لأنّ لمقرّبية العمل دخلاً في صحّة المأتيّ به إذا كان عبادياً، ولا يمكن أن يكون فعل المبغوض والمبعِّد عن المولى مقرّباً، قلنا بجواز الاجتماع أو امتناعه.
ص: 283
قسّم الشيخ(قدس سره) - كما أفاد بعض مقرّري بحثه - النواهي الواردة في العبادات إلى قسمين:
أحدهما: ماهو منساق لبيان المانع، كالأوامر الواردة في العبادات لبيان الأجزاء والشرائط، ولا إشكال في دلالة هذه النواهي على الفساد، بل ذلك لا يخلو عن مسامحة، فإنّ الفساد الواقعيّ إنّما أوجب النهي عن العبادة المقارنة للمانع، لا أنّ النهي اقتضى الفساد.
وثانيهما: ما هو منساق لتحريم أصل العبادة من دون إرشاد إلى عدم وقوع الامتثال بها، كقولك: «لا تصلّ في الدار المغصوبة» غير قاصد بذلك رفع الإذن الحاصل من إطلاق الأمر بالصلاة، وهذا ينبغي أن يكون محلّا للنزاع، ثم أفاد بأنّه يقتضي الفساد.((1))
وقسّم(قدس سره) النواهي الواردة في المعاملات إلى أقسام:
أحدها: أن يكون النهي متعلّقاً بالمعاملة من حيث إنّها أحد أفعال المكلّف فيكون إيجاد السبب والتلّفظ بالإيجاب والقبول مثلاً وقت النداء مثل شرب الخمر محرّماً من غير ملاحظة أنّ هذا الفعل المحرّم يوجب نقلاً وانتقالاً. ولا ريب في عدم دلالة هذا النحو من النهي على الفساد.
ثانيها: أن يكون مفاد النهي مبغوضية إيجاد السبب لا من حيث إنّه فعل من الأفعال بل من حيث إنّ ذلك السبب يوجب وجود المسبّب المبغوض في نفسه، كما في النهي عن بيع المسلم للكافر؛ فإنّ إيجاد السبب حرام بواسطة إيراثه أمراً مبغوضاً وهو سلطنة الكافر على المسلم بناءً على الصحّة ووجوب الإجبار على إخراجه عن ملكه.
ص: 284
فلو قلنا بأنّ الأسباب الناقلة إنّما هي مؤثّرات عقلية قد اطّلع عليها الشارع وبيّنها لنا من دون تصرّف زائد يمكن القول في هذا القسم بعدم دلالة النهي على الفساد.
وأمّا إن قلنا بأنّ هذه أسباب شرعية وضعها الشارع وجعلها مؤثّرة في الآثار المطلوبة فلابدّ من القول بالفساد؛ فإنّ من البعيد جعل السبب مع كون المسبّب مبغوضاً.
ثالثها: أن يكون مفاد النهي حرمة الآثار المترتّبة على المعاملة المطلوبة منها، مثل ما يدلّ على حرمة أكل الثمن فيما إذا كان عن الكلب والخنزير. وهذا النهي یدلّ بالالتزام على عدم حصول الملك بهذه المعاملة وهو عين الفساد؛ لأنّه لا وجه لحرمة التصرّف في الثمن والمبيع ونحو ذلك من الآثار المترتّبة على الملك لو حصل الملك.
رابعها: أن يكون النهي ناظراً إلى إطلاق دليل الصحّة فيكون لا محالة مقيّداً لإطلاقه ويكون مفاده التصريح بالدلالة على الفساد، فكأنّه بمنزلة الاستثناء لقوله مثلاً «أوفوا بالعقود» الدالّ على حصول الملك والنقل والانتقال بالعقد.((1))
خامسها: وهو الّذي زاده المحقّق الخراساني(رحمه الله) على هذه الأقسام، وهو: تعلّق الحرمة بالتسبّب بالمعاملة الخاصّة إلى مضمونها، فالنهي متعلّق على هذا بالتوسّل من هذا السبيل وإيجاد ذلك السبب الخاصّ إلى مسبّبه. وذهب إلى عدم دلالة النهي في هذا القسم أيضاً على الفساد.((2))
ولا يخفى عليك: أنّه يمكن إنكار النهي المتعلّق بالسبب في الشرعيات كما ذكره في القسم الأوّل؛ فإنّ البيع وقت النداء وما كان من هذا القبيل لا يكون منهيّاً بما هو فعل مباشري، بل النهي قد تعلّق حقيقة بحقيقة المعاملة وما يعبّر عنه بالفارسية ب- «داد و
ص: 285
ستد» لكن لا من جهة مبغوضية أصل المعاملة بل من جهة مزاحمتها مع السعي إلى ذكر الله. وهذا الملاك موجود في کلّ فعل يزاحم السعي.
وهذا النهي لا يكون إلّا غيرياً وليس فيه دلالة على الفساد ولا على حرمة المعاملة أصلاً، فإذا ترك الصلاة واشتغل بالمعاملة لا يكتب عليه معصيتان.
وأمّا ما كان من قبيل القسم الخامس وهو تعلّق النهي بالتسبّب، فالقول فيه بدلالة النهي على الفساد قريب؛ لأنّ الشارع حيث أراد عدم التوصّل بذلك السبب الخاصّ إلى المسبّب يقتضي هذا إلغاء سببيته رأساً، فالنهي المتعلّق بالمسبّب يكون إرشادياً لا محالة.
والّذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّا نرى العلماء في الأبواب المتفرّقة من الفقه كثيراً ما يستدلّون بالنهي على فساد المعاملة،((1)) كالنهي عن بيع الغرر وعن بيع المنابذة وعن نكاح منكوحة الأب وغيرها. ومن الواضح أنّه ليس ذلك من أجل دلالة النهي لغة على الفساد بل ولا شرعاً؛ لأنّه لا يدّعي أحد أنّ الشارع وضعه للدلالة على الفساد بعدما لم يكن كذلك في اللغة.
فما ينبغي أن يكون وجهاً لهذا أنّه كما أنّ الأسباب الناقلة كالإيجاب والقبول ليست مطلوبات نفسية لأرباب المعاملات، بل وليست مسبّباتها أيضاً - من قبيل الملكية والزوجية - مطلوبات نفسية، وإنّما هي أسباب يوجدها الناس لأجل الآثار الّتي تترتّب على مسبّباتها، كجواز التصّرف في الثمن والمثمن بسبب الإيجاب والقبول، وحصول الملكية في البيع، وجواز الوط ء بسبب الإيجاب
ص: 286
والقبول، وحصول الزوجية في النكاح، فلا يكون النهي المتعلّق بهذه الأسباب متعلّقاً بها وبمسبّباتها حقيقة، بل النهي إنّما يتعلّق بالأثر المترتّب على المسبّب الّذي لأجله يوجد السبب وما هو مطلوب نفسي، فالنهي المتعلّق بالمعاملة ليس مفاده حرمة إيجاد السبب والمسبّب، بل مفاده النهي عن ترتيب الأثر على المعاملة والعمل بمضمونها ليس إلّا، هذا.
قد استدلّ لدلالة النهي على فساد المعاملة بروايات، أمتنها متناً ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده؟ فقال: «ذاك إلى سيّده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بينهما». قلت: أصلحك الله إنّ الحَكَم بن عتيبة وإبراهيم النَّخعي وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، ولا يحلّ إجازة السيّد له. فقال أبو جعفر(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «إنّه لم يعص الله، إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز».((1))
وجه الدلالة: أنّ مقتضى قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لم يعص الله... إلخ» أنّ النكاح لو كان ممّا حرّمه الله تعالى كان فاسداً، فمراده (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) - على الظاهر - أنّ النكاح حيث لم يكن ممّا حرّمه الله ولم يمضه لا يقع فاسداً، لأنّ هذا النكاح لا يقع معصية لله تعالى. فلو كان معصية لله تعالى وممّا لم يمضه يكون فاسداً؛ لأنّه يستتبع الفساد لا محالة.
وقريبة منها روايته الاُخرى عن أبي جعفر(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل تزوج عبدُه
ص: 287
امرأةً بغير إذنه فدخل بها، إلى آخر الرواية.((1)) ولعلّهما رواية واحدة لبعد تكرّر هذا السؤال من زرارة عن الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ).
وأمّا رواية البقباق عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، قال: قلت لأبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): الرجل يتزوّج الأمة بغير علم أهلها قال: «هو زنى، إنّ الله يقول: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾((2))».((3))
فلا دلالة لها على ما نحن بصدده، كما لا يخفى.
حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحّة.((4))
فإن كان مرادهما من ذلك أنّ النهي یدلّ على الصحّة بالمعنى الّذي حقّقناه، وهو: تحقّق المنهيّ عنه على نحو يترقّب أن يوجد ويتحقّق، فهو صحيح.((5)) وإن كان مرادهما كون المنهيّ عنه مأموراً به وقابلاً لأن يتقرّب به، فلا دلالة له على ذلك. والله العالم.
ص: 288
ص: 289
وفيه فصول:
الفصل الأوّل: في معنى المنطوق والمفهوم
الفصل الثاني: في المنشأ وما يحصل به المفهوم
الفصل الثالث: في مفهوم الشرط
الفصل الرابع: في المفهوم في الجمل الإنشائية
الفصل الخامس: هل المراد انتفاء سنخ الحكم أو شخصه؟
الفصل السادس: في تعدّد الشرط ووحدة الجزاء
الفصل السابع: في تداخل الأسباب والمسبّبات
الفصل الثامن: في تطابق المفهوم مع المنطوق
ص: 290
ص: 291
والحقّ: أنّ المنطوق والمفهوم من صفات المدلول. وانقسامه إليهما من جهة اختلاف خصوصية الدلالة، فباعتبار وجود إحدى الخصوصيتين في دلالة الكلام يسمّى المدلول مفهوماً، أو منطوقاً. ولا يوجب هذا كونهما من صفات نفس الدلالة وإن كان ربما يوجد في كلماتهم تقسيمها إلى المفهومية والمنطوقية.
فدلالة اللفظ تارة: تكون بحيث يسمّى مدلوله بحسب هذا النحو من الدلالة مفهوماً. واُخرى: تكون بحيث يسمّى مدلوله منطوقاً.
وربما يظهر من كلمات القدماء عدم وضوح مفادهما عندهم، ولذا وقع الاختلاف بينهم في أنّ دلالة الغاية في ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾((1)) على عدم وجوب الصوم بعد الليل، هل تكون بالمفهوم أو بالمنطوق؟
وعلى کلّ حال فلا يخفى عليك: أنّ الشيخ(رحمه الله) بعدما أفاد انحصار المدلول المطابقي في المنطوق وكذلك المدلول التضمّني - إلّا على قول من زعم أنّ دلالة الجملة الشرطية على الحكم المفهومي إنّما هي بالتضمّن؛ فإنّه على هذا ينقسم المدلول التضمّني إلى المفهوم والمنطوق - وانقسام المدلول الالتزامي إليهما، ونقل تعريف
ص: 292
الحاجبي وتفسير العضدي له، وغير ذلك؛((1)) أفاد في ذيل كلامه بأنّ التحقيق في المقام: أن يقال: إنّ لوازم المداليل المفردة خارجة عن المقسم. وأمّا المداليل الالتزامية للمركّبات، فما كان منها لا يقصد دلالة اللفظ عليه وإن كان يستفاد منه، يكون خارجاً عن المفهوم. وما كان يقصد دلالة اللفظ عليه، فإن كان الحكم المستفاد من الكلام المنطوق به مفاده مفاد قولك لا غير، كما في مفهوم المخالفة مثل قولك: زيد قائم غير عمرو. أو كان الحكم ثابتاً للغير على وجه الترقّي كما في مفهوم الموافقة فهو المفهوم بقسميه، وإلّا فهو المنطوق.
وبعدما أفاد في توضيح مراده هذا، قال في آخر كلامه: بأنّه غاية ما يمكن أن يقال، إلّا أنّه بعد إحالة على المجهول.((2))
وهكذا حال غيره ممّن تأخّر عنه، فلم يأتوا بما يوضح مفادهما ويظهر به حقيقتهما.
والّذي ينبغي أن يقال: إنّ الدلالات الثلاث كلّها منطوقية، وليست إحدى منها مقسماً للمنطوق والمفهوم. وكما أشرنا إليه أنّ مفادهما ليس مجهولاً عندهم كما زعمه الشيخ(رحمه الله) وغيره، بل الظاهر أنّهما عندهم بمكان من الوضوح، وعدم اختلاف بينهم في مفادهما. فما یدلّ عليه اللفظ في محلّ النطق هو المنطوق. وما یدلّ عليه لا في محلّ النطق هو المفهوم.((3))
ومرادهم من هذا التعريف: أنّ الّذي يستفاد من كلام المتکلّم ويصحّ أن يقال بأنّه قال كذا وتكلّم بكذا أو أخبر عن كذا أو أمر بكذا ونهى عن كذا، ويصحّ أن يحتجّ بسببه معه بأنّك قلت هكذا وأمرت بكذا، ولا يصحّ له أن ينكره، هو المنطوق. وأمّا ما
ص: 293
لا يكون كذلك ويمكنه في مقام الاحتجاج إنكار التكلّم به وأن يقول ما نطقت به، ولا يقال فيه: إنّه قال كذا، هو المفهوم.
فعلى هذا، يكون المفهوم خارجاً من الدلالات الثلاث.
ولا يخفى عليك: أنّ الدلالات بحسب اصطلاحهم غيرها بحسب مصطلح المنطقيّين؛((1)) فإنّ تقسيمهم راجع إلى الألفاظ المفردة ومرادهم من الدلالة الالتزامية ما یدلّ عليه اللفظ بالالتزام في عالم الذهن والتصوّر، و يكون لازم وجود المعنى المطابق في عالم الذهن، سواء كان لازماً لوجوده الخارجي أو لم يكن، بل كان مبايناً معه كالعمى والبصر.
وأمّا الدلالات بحسب اصطلاح الاُصوليّين فتقسيمهم إيّاها راجع إلى الألفاظ المرکّبة. فدلالة الجملة على مجموع ما تدلّ عليه أجزاؤها المفردة موسومة بالمطابقة، فاتّحاد الموضوع وهو زيد مع المحمول وهو القيام بحيث يكون الموضوع معروضاً له وكان القيام قائماً به، هو المعنى المطابقي.
ودلالة الجملة على جزء هذا المعنى وهو كون بعض أجزائه كرِجله أو رأسه أو غيرهما معروضاً لوضع خاصّ ومتّحداً معه، عبارة عن التضمّن.
ودلالة الجملة على لوازم هذا المعنى - لكن لا على ما كان لازمه بحسب الذهن، أي لازم وجوده الذهني كما استقرّ عليه اصطلاح المنطقيين، بل على ما كان لازم وجوده الخارجي - تسمّى بالالتزام.
وهذه الدلالات الثلاث كلّها دلالات منطوقية، وليست واحدة منها مفهومية؛ فإنّه يصحّ الاحتجاج مع المتکلّم بکلّ واحدة منهنّ، ويصحّ أن يقال بأنّك قلت هكذا أو أخبرت عن هذا، بالنسبة إليهنّ على السواء.
ص: 294
وبالجملة: الغرض من ذلك كلّه: بيان أنّ المفهوم ليس من الدلالات الثلاث حتى يقال بأنّ حجّیته لو ثبت أصله غنيّة عن البيان، وأنّ النزاع واقع في الصغرى كما زعمه المتأخّرون،((1)) ولذا نرى أنّ القدماء يستدلّون لحجّية مفهوم الشرط وغيره من المفاهيم بأنّه لو لم تكن حجّة لكان أداء الكلام بهذا النحو لغواً، فيفهم من هذه عدم كون المفهوم عندهم من الدلالات الثلاث،((2)) وأنّ النزاع يكون كبروياً وإلّا لما احتاجوا إلى الاستدلال لحجّيته.
والمتأخّرون حيث اشتبه عليهم ذلك وتوهّموا أنّه قسم من المدلول بالدلالة الالتزامية صاروا في مقام إثبات أصل المفهوم من طريق ظهور ذكر العلّة على انحصارها.((3))
والحاصل: أنّ تمسّك القدماء لحجّية المفهوم بدخالة القيد في ثبوت الحكم وإلّا يلزم كون القيود المذكورة في الكلام لغواً، یدلّ على أنّ المفهوم غير المداليل الّتي یدلّ عليها اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث، وأنّ النزاع الواقع في المقام لا يكون إلّا كبروياً.
لا فرق فيما ذكر بين مفهوم المخالفة وهو: ما يفهم من تقيّد الكلام بقيد من القيود من عدم ثبوت الحكم للمقيّد بما هو ودخالة ذلك القيد في ثبوت الحكم، وبين مفهوم
ص: 295
الموافقة وهو: ما يستفاد عرفاً من الكلام المقيّد بقيد من عدم دخالة ذلك القيد في الحكم، وثبوت الحكم لموضوع كان فاقداً لهذا القيد، استفيد ذلك من جهة أولوية الفاقد كما في الآية: ﴿فَلَا تَقُلْ لَ-هُما اُفٍّ﴾،((1)) فإنّ العرف يفهمون أنّه ليست لحرمة التأفيف خصوصية وإنّما ذكر لأجل أنّه أحد مصاديق الظلم على الوالدين، فحرمة ما ليس تأفيفا بل كان من قبيل الضرب والشتم أولى. أو من غير جهة الأولوية كما إذا قال: «إذا شكّ الرجل بين الثلاث والأربع يبني على الأربع»، فإنّ العرف يفهم من ذلك عدم دخالة قيد الرجولية في الحكم، وأنّه حكم شكّ المرأة أيضاً.
وممّا ذكر((2)) يظهر: أنّ ما استشكلوا على الشريف المرتضى(قدس سره) - في استدلاله على عدم حجّية المفهوم بقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾؛((3)) وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾؛((4)) بأنّه لو كان المفهوم حجّة لما قامت إمرأتان مقام أحد الشاهدين.((5)) وإشكالهم عليه - أوّلاً وثانياً وثالثاً وبأنّ هذا الاستدلال بعيد عن محلّ البحث، ولا يليق بمقام السيّد(رحمه الله) ((6)) - في غير محلّه؛ لأنّ نظر السيّد(رحمه الله) إنّما يكون على إبطال استفادة دخالة القيد في الحكم، لا نفي دلالتهما على عدم الاكتفاء بشاهد واحد، وسيجيء لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى.
ص: 296
هذا تمام الكلام في أصل المفهوم. وتلخّص منه أنّ الدلالة إذا كانت لفظيةً كالدلالات الثلاث يكون مدلولها منطوقاً، وإذا كانت غير لفظية يكون مدلولها مفهوماً.
ص: 297
يمكن أن يقال: إنّ العرف يستفيد المفهوم من نفس التلفّظ والتكلّم بما أنّه فعل اختياريّ، صوناً لفعل الحكيم من اللغوية؛ فإنّ في صورة الشكّ في كون المتکلّم في تکلّمه، بل وكلّ فاعل في فعله يكون لاغياً أو لا؟ استقرّ بناء العرف والعقلاء على عدم كونه لاغياً، بل أنّه فَعَلَ ما فَعَلَ لغرض ومقصد. وهذا الأصل يكون حجّة ومتّبعاً عند العقلاء، ولهذا لو اعتذر العبد في مخالفة مولاه بأنّي احتملت أن يكون لاغياً، لا يسمع منه.
وهذا الأصل يجري مقدّماً على إجراء أصالة كون غرض المتکلّم إفادة معنى من المعاني فيما إذا شكّ في أنّ المتکلّم في مقام الإفادة أو تكلّم لغرض آخر، كدفع شرّ ظالم أو غيره.
كما أنّ إجراء هذا الأصل الأخير أيضاً يكون مقدّماً على أصالة إرادة المعنى الحقيقي.
وكيف كان، فيما إذا كان المتکلّم في مقام الإفادة ولم يكن لاغياً وكان كلامه متضمّناً لزيادات على الموضوع والمحمول يفهم من نفس تكلّمه دخالة هذا الزائد في مقصوده؛ فإنّ العرف يفهم من إتيان المتکلّم بقيد في كلامه - من جهة أنّ تکلّمه فعل من الأفعال، لا من جهة دلالة لفظ القيد على معناه - أنّ للقيد دخالة في ثبوت الحكم. ويفهم من ذلك عدم ثبوت الحكم لما كان فاقداً لهذا القيد. فالمفهوم هو: ما يستفاد من تقييد كلام المتکلّم بقيد. وأمّا مفهوم الموافقة فهو في الحقيقة لا يستفاد من اشتمال
ص: 298
الكلام على قيد زائد، بل إنّما يستفاد من كون تقيّد الموضوع بهذا القيد من باب كونه أحد الأفراد والمصاديق لما هو الموضوع أو أنّه فرد دانيّ له، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَ-هُ-مَا اُفٍّ﴾،((1)) فإنّ العرف يحكم بعدم دخالة هذا القيد في الموضوع، وثبوته لما كان فاقداً له.
ولو أغمضنا عن ذلك ولم نقل بأنّ اشتمال الكلام على القيد يفيد دخالته في الحكم من جهة أنّه فعل من الأفعال، فلا يمكن القول باستفادة المفهوم بما ذكره المتأخّرون من دلالة تقييد الحكم بواسطة كلمة «إن» على الانتفاء عند الانتفاء، من جهة أنّ ظاهر القضیّة الشرطية سببية الشرط للجزاء على وجه الانحصار.
وذلك من جهة أنّ مفاد القضیّة الشرطية إذا كان عليّة الشرط للجزاء لا يفيد الانتفاء عند الانتفاء أصلاً، فلو قال الطبيب للمريض: «إن شربت الماء يزيد مرضك»، أو قال المنجّم: «إذا اجتمع الكوكب الفلاني مع كوكب آخر تقع في العالم حادثة مهمّة» فلو أكل المريض البطّيخ وصار سبباً لشدّة مرضه، أو وقعت في العالم الحادثة المذكورة من دون اجتماع الكوكبين، لا يصحّ الاعتراض على الطبيب، فإنّ له أن يقول: ليس لازم قولي عدم سببية غير الماء لشدّة المرض. وهكذا في جانب المنجّم.
نعم، إذا كان المتکلّم في مقام بيان تمام ما هو المناط لترتّب الحكم على الموضوع وأتى بقيد زائد، فظاهره كما مرّ هو: الانتفاء عند الانتفاء، كقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «إذا کان الماء قدر كُرٍّ لم ينجّسه شيء».((2))
وملخّص الكلام في المقام: أنّ المتکلّم الحكيم الّذي يكون في مقام الإفادة إذا أتى في
ص: 299
كلامه بقيد زائد في طرف الموضوع أو المحمول لابدّ وأن يفيد ذلك القيد دخالته في الحكم صوناً لفعله وتكلّمه من اللغوية.
هذا تمام الكلام فيما يحصل به المفهوم.
وأمّا الكلام في مفاده، فلا ريب في دلالته على أنّ المقيّد بما هو هو، أي من دون قيده، ليس موضوعاً للحكم، ولكن لا دلالة له على عدم كون المقيّد موضوعاً للحكم إذا كان فاقداً للقيد المذكور في الكلام وواجداً لقيد آخر. فلا يفيد المفهوم أكثر من دخالة القيد، وأنّ المقيّد في نفسه وبحسب ذاته لا يكون مرْكباً للحكم. فعلى هذا، لا مانع من ضمّ قيد آخر إليه يقوم مقامه، فقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «الماء إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء»، لا يفهم منه إلّا دخالة الكرّية في موضوع حكم الشارع بعدم التنجّس وأنّ نفس الماء مجرّداً عن القيد ليس موضوعاً للحكم، لا أنّ تمام الموضوع لهذا الحكم هو الماء إذا كان كرّاً، فلا يفهم منه تنجّسه بشيء ولو ضمّت إليه خصوصية اُخرى تقوم مقام القيد المذكور ككونه جارياً أو مطراً.
نعم، إذا كان المتکلّم في مقام بيان تمام ما هو مناط الحكم واُحرز ذلك، فلا مانع من أخذ المفهوم والحكم بأنّه ينجّسه شيء ولو ضمّت إليه خصوصية اُخرى، ولعلّ هذا مراد كاشف الغطاء(رحمه الله) في المقام، حيث أفاد: أنّ المتکلّم إذا كان في مقام البيان يستفاد هذا من كلامه، وإلّا فلا.
وممّا ذكرنا ظهر مراد السيّد المرتضى(رحمه الله)، فإنّه في مقام الجواب عن القائل بالانتفاء عند الانتفاء مطلقاً ولو قام قيد آخر مقام القيد المذكور، فأفاد بأنّ تقيّد الموضوع بقيد لا یدلّ على أزيد من دخالة القيد في الحكم وأنّه لا يكون بما هو هو موضوعاً، وليس
ص: 300
فيه دلالة على أنّ الحكم يدور مدار ذلك القيد مطلقاً، ألا ترى في قوله تعالى: ﴿وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾((1)) مع أنّه یدلّ على عدم جواز قبول شاهد واحد إلّا إذا انضمّ إليه شاهد آخر، لا يمنع من قبول شاهد واحد إذا انضمّت إليه إمرأتان أو خصوصية اُخرى.((2))
وغرضه من ذلك أنّ تقيّد المقيّد بقيد لایدلّ على أزيد ممّا ذكر، كما أنّه يستفاد من الآية دخالة ضمّ شاهد آخر في جواز القبول وعدم جواز قبول شاهد واحد بما هو هو، ولكن لا يستفاد منه عدم جواز القبول في صورة ضمّ ضميمة اُخرى إليه، وهذا كما ترى كلام تحقيقي متين.
تتمة: في تعريف المفهوم في الكفاية أفاد المحقّق الخراساني(رحمه الله) في تعريف المفهوم، بأنّه عبارة عن: «حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الّذي اُريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة وكان يلزمه لذلك... إلخ».((3))
ويمكن أن يستظهر ممّا يفيد في مفهوم الشرط والوصف((4)) أنّ تلك الخصوصية المستتبعة لذلك الحكم المفهومي ليست إلّا انحصار العلّة.
ولا يخفى ما في هذا الكلام من الاضطراب؛ لأنّ تلك الخصوصية إن اُريدت من اللفظ فهي داخلة في المعنى، ويصير معناه بناءً على هذا: أنّ المفهوم حكم إنشائي أو إخباري يكون لازماً للمعنى الّذي اُريد من اللفظ ولازمه أن يكون المفهوم من المداليل الالتزامية. وإن لم ترد من اللفظ، فهي خارجة عن مدلول اللفظ. مضافاً إلى أنّ
ص: 301
هذه الخصوصية كانحصار العلّة لا تلازم المعنى الّذي اُريد من اللفظ وهو علّية الشرط للجزاء؛ لأنّها كما يمكن أن تكون منحصرة، يمكن أن تكون غير منحصرة.
وبالجملة: وإن أشار(قدس سره) إلى أنّ هذه التعريفات شرح الاسم إلّا أنّه لابدّ من أن يكون شرح الاسم وما يشار به إلى المعرَّف ممّا يصحّ أن يشار به، هذا.
وقد أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين في المقام بأنّ انفهام معنى تركيبي من جملة تركيبية إن كان باعتبار نفس الجملة في حدّ ذاته تكون الدلالة منطوقية. وإن كان باعتبار لزومها لمفاد الجملة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ، حتى تكون الدلالة لفظية، فتكون الدلالة مفهومية. وبنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ، حتى لا تكون الدلالة لفظية، فتكون سياقيه كدلالة الاقتضاء((1)) ودلالة التنبيه((2)) ودلالة الإشارة.((3)) ولا فرق في ذلك بين دلالة جملة واحدة كدلالة قوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «كفّر» في جواب من قال «هلكت وأهلكتُ، واقعت أهلي في نهار شهر رمضان»((4)) على علّية
ص: 302
الوقاع للتكفير؛ وبين دلالة الجملتين كدلالة الآيتين الشريفتين((1)) على كون أقلّ الحمل ستة أشهر.((2))
وفيه: أنّ دلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه إنّما تكون من الدلالات المنطوقية،((3)) وليس لنا دلالة اُخرى في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية تكون موسومة بالدلالة السياقية.
ص: 303
نبحث هنا في مفهوم الشرط على مسلك المتأخّرين وإن كان خلاف ما ذهبنا إليه. وحاصل ما أفاد في الكفاية في المقام: أنّ إثبات المفهوم موقوف:
أوّلاً: على إثبات أنّ القضیّة الشرطية لزومية لا اتّفاقية.
وثانياً: على إثبات دلالة الجملة على نحو الترتّب؛ لأنّه يمكن أن يكون الشرط والجزاء معلولين لعلّة ثالثة.
وثالثاً: على إثبات أنّ الترتّب يكون على نحو الترتّب على العلّة بمعنى ترتّب الجزاء على الشرط الّذي هو علّته.
ورابعاً: على إثبات أنّه على نحو ترتّب المعلول على العلّة المنحصرة.
فمنكر المفهوم في سعة وفسحة.
وأمّا القائل بالمفهوم مستدلاً بالتبادر، فلا يمكن له إثباته.
وأمّا ادّعاؤه: انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها، وهو اللزوم بين العلّة المنحصرة ومعلولها.
ففاسد؛ لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف. ولعدم كون العلّة المنحصرة أكمل من غيرها.
ص: 304
كما أنّه لا وجه للتمسّك بما هو قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما يتمسّك بقضية إطلاق صيغة الأمر لإثبات الوجوب النفسي؛ لأنّ التمسّك بالإطلاق بمعونة مقدّمات الحكمة لا يكاد يتمّ فيما هو مفاد الحرف كما في المقام، وإلّا لم يكن المعنى حرفياً.
هذا، مضافاً إلى أنّ کلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب تعيينه محتاج إلى القرينة، كان اللزوم والترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة أو لا .
ولا يقاس المقام بالواجب النفسي والغيري؛ فإنّ النفسي واجب على کلّ تقدير، دون الغيري فإنّه واجب على تقدير الوجوب النفسي فبيانه محتاج إلى مؤونة التقييد بما إذا كان الغير واجباً، فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدّمات الحكمة محمولاً على الوجوب النفسي.
وأمّا الاستدلال على المفهوم بإطلاق الشرط، بتقريب: أنّ الشرط لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده، ضرورةَ أنّه لو قارنه أو سبقه أمر آخر لم يؤثّر وحده، وقضيّة إطلاقه تأثيره كذلك مطلقاً.
ففيه: أنّه لا يكاد أن يصحّ إنكار المفهوم مع إطلاقه كذلك، إلّا أنّه لو لم نقل بعدم اتّفاقه لا ريب في ندرة تحقّقه.
وأمّا لو قيل: بأنّ مقتضى إطلاق الشرط تعيّنه كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر هو تعيّن الوجوب.
فيدفع: بأنّ الواجب التعييني هو الواجب الّذي تعلّق به الوجوب معيّناً من غير أن يكون له عدل، بخلاف التخييري فإنّ الوجوب يتعلّق فيه بأحد الشيئين أو الأشياء على سبيل الترديد، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق لإثبات الواجب التعييني؛ لأنّه ليس له عدل، وما له العدل محتاج إلى زيادة مؤونة. وهذا بخلاف الشرط، فإنّه - واحداً كان أم متعدّداً - يكون دخله في المشروط على نحو واحد، ولا تتفاوت الحال فيه
ص: 305
ثبوتاً حتى يقال بتفاوته إثباتاً. واحتياج ما إذا كان الشرط متعدّداً إنّما يكون لبيان تعدّده لا لبيان نحو تأثيره في المشروط، فحيث كانت القضية مسوقة لبيان الشرطية من غير إهمال ولا إجمال لا تتفاوت نسبة إطلاق الشرط إلى المشروط، كان هناك شرط آخر أم لا؟ بخلاف إطلاق الأمر، فإنّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون في مقام الإهمال والإجمال.((1)) هذا حاصل ما أفاده في الكفاية.
ويمكن أن يزاد على هذه الوجوه الخمسة الّتي أجاب عنها(قدس سره) وجهاً سادساً، وهو: ما أوردناه عليه في مجلس بحثه: بأنّ الشرط إمّا يكون مؤثّراً في المشروط بشخصه وخصوصيته؛ وإمّا أن لا يكون مؤثّراً كذلك، بل بما أنّه أحد مصاديق العلّة، ويكون مؤثّراً فيه من جهة أنّه واجد لما هو الجامع بينه وبين سائر مصاديقها فيؤثّر بهذه الجهة، وظاهر اختصاص هذا الشرط بالذكر أنّه هو المؤثّر في وجود المشروط، ويكون علّة له بشخصه وخصوصيته، فانتفاؤه يكون مستلزماً لانتفاء المشروط، ولا نعني بالمفهوم إلّا هذا.
وقد أجاب عنّا: بأنّ التفطّن بهذا لا يحصل إلّا بعد إعمال التأمّل والدقّة العقلية، وهذا لا يساعده ابتناء المحاورات على العرفيات.
ص: 306
ص: 307
إذا قال: «أوقفت مالي (أو وقفت مالي) على أولادي الفقراء (أو إن كانوا فقراء)» فهل يصحّ أن يقال فيه بالمفهوم أو لا؟
الظاهر: أنّ الوقف حيث تكون حقيقته حفظ العين وإبقاءه على عنوان أو أشخاص، بحيث يدرّ على المعنون، ووجوده يتحقّق بإنشاء الواقف وإيجابه، فإذا قال: «أوفقتُ مالي على أولادي إن كانوا فقراء» جعل العين على أولاده معلّقاً على هذا الشرط، ففي صورة انتفاء الشرط لا يصحّ أن يقال بانتفاء المشروط وهو وقف هذا المال على أولاده؛ لأنّ عدم تعلّق الوقف بهم لو لم يكونوا فقراء ليس من جهة المفهوم ودلالة قوله: «أوقفت... إلخ» على الانتفاء عند الانتفاء، بل انتفاء الحكم عن غير هذا المورد إنّما يكون لأجل أنّ إيجاد الواقف وإنشاءه لم يتعلّق بالعين إلّا بشرط كونهم فقراء وعدم تعلّق إنشائه بغير هذا المورد.
والحاصل: أنّه لا يصحّ في الإنشائيات والإيجاديات القول بالمفهوم؛ لأنّنا ندور فيها مدار الإنشاء والإيجاد، فبعد العلم بأنّ الإنشاء والإيجاد لم يتعلّق بغير هذا المورد وأنّ تعلّقه بغيره يحتاج إلى إنشاء يخصّ به، لا يصحّ أن يقال بأنّ قوله: «إن جاءك زيد فأكرمه» إذا كان في مقام الإنشاء لا الإخبار يفيد المفهوم على القول به؛ لأنّ إيجاد الوجوب وإنشاءه لم يتعلّق بإكرامه إلّا بشرط مجيئه، فعدم وجوب إكرامه على تقدير
ص: 308
عدم مجيئه ولو تخصّص بخصوصية اُخرى لا يكون من باب المفهوم، بل من جهة عدم تعلّق الإنشاء إليه وعدم كون غير هذا الشخص من وجوب الإكرام.
نعم، لا مانع من القول بالمفهوم في الإخباريات كما لو قال: «إذا جاء زيد يجب إكرامه»؛ وفي الإنشاءات الإرشادية مثل ما هو الغالب في أوامر الأنبياء والأئمّة - صلوات الله عليهم - وأوامر العلماء، حيث إنّهم إذا كانوا في مقام بيان الأحكام لا يأمرون مولوية بل يرشدون الناس إلى أحكام الله تعالى. ففي مثل هذه الموارد لا مانع من جريان نزاع المفهوم كما لا يخفى، فتدبّر واغتنم.((1))
ص: 309
لا يخفى عليك: أن على القول بالمفهوم ليس معناه انتفاء سنخ الحكم كما ذهب إليه الشيخ(رحمه الله)((1)) ومن تأخّر عنه؛((2)) لأنّ الجزاء المعلّق على الشرط لا يكون إلّا جزئياً، كالوجوب المعلّق على المجيء، فبانتفاء الشرط لا ينتفي إلّا ذلك الحكم المنشأ في هذا الظرف. فكما أنّ بانتفاء هذا الشرط لا يصحّ أن يقال بانتفاء وجوب إكرام عمرو ووجوب إكرام خالد، لا يصحّ أيضاً أن يقال بانتفاء نوع الحكم المعلّق على الشرط.
فلا معنى لما أفاد في الكفاية بأنّ المعلّق على الشرط هو نوع الوجوب.((3))
لأنّ النوع يمتنع أن يوجد من غير أن يتشخّص بالخصوصيات المفردة، فلا يصحّ أن يتعلّق به الإنشاء والإيجاد.((4))
ص: 310
ثم إنّه لا يخفى عليك: ما في عبارة التقريرات من أنّ انتفاء شخص الحكم لازم ارتفاع الكلام الدالّ على الإنشاء.((1))
لأنّ لازم هذا الكلام وحاصله: أنّ الحكم بشخصه ينتفي بمجرّد تمامية كلام المتکلّم؛ لأنّه من الموجودات غير القارّة. وبطلان هذا واضح؛ لأنّ بقاء الحكم ليس وجوده دائراً مدار بقاء الكلام، بل الحكم ينتزع من كلام المتکلّم وله بقاء في عالم الاعتبار إلى أن يسقط بالامتثال أو العصيان أو ذهاب موضوعه، فتأمّل جيّداً.
ص: 311
مثال ذلك: «إذا خفي عليك جدران البلد فقصِّر»،((1)) و«إذا خفي عليك أذان المصر فقصِّر». فقيل برفع اليد عن المفهوم في كليهما.
وقيل بتخصيص مفهوم کلّ منهما بمنطوق الآخر، فينتفي وجوب القصر عند انتفائهما، بخلاف الوجه الأوّل فإنّه ليس لهما دلالة على عدم دخالة شيء ثالث في الجزاء لإلغاء مفهومهما رأساً.
وقيل بتقييد إطلاق الشرط في کلّ منهما بالآخر، حتى يكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معاً، فلا يجب القصر عند انتفاء خفاء أحدهما، ويجب عند وجود كليهما.
وقيل بأنّ الشرط هو القدر المشترك وما هو الجامع بينهما.
ولا يخفى: أنّ رفع اليد عن مفهوم کلّ منهما - كما في الوجه الأوّل - خلاف الظاهر في مثل هذا المقام الّذي تكون القرينة لوجود المفهوم في الجملة موجودة ولو لم نقل بالمفهوم في الجملة الشرطية أصلاً.
وأمّا الوجه الثاني: فتخصيص المفهوم بالمنطوق بعيد من جهة أنّ المفهوم يستفاد من دلالة التكلّم على مسلك القدماء أو من دلالة الجملة الشرطية على العلّية المنحصرة
ص: 312
على مذهب المتأخّرين. وعلى کلّ حال، فلا يكون مفاد المفهوم مثل العموم حتى يمكن أن يقال بتخصيص الإرادة الاستعمالية وعدم تعلّق الإرادة الجدّية بالعموم.
وأمّا الوجه الثالث: فهو أيضاً خلاف الظاهر.
ولا يبعد أن يقال بأنّ الوجه هو الرابع، كما لا يخفى.
ص: 313
إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء - سواء كان الشرط من جنس واحد، كما لو قال: كلّما نمت فتوضّأ، أو كلّما بلت فتوضّأ؛ أو لم يكن من جنس واحد بل كان مختلفاً، كما إذا قال: إذا نمت فتوضّأ، وإذا بلت فتوضأ، ممّا يكون الظاهر فيه حدوث الجزاء، وهو الوجوب المتعلّق بطبيعة عند وجود الشرط - فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعدّداً((1)) أو لا؟((2)) فيه أقوال. وقبل الخوض في الكلام ينبغي تحرير محلّ النزاع.
إنّ تمام الاختلاف يرجع إلى أنّ تعدّد الشرط هل يكون موجباً لتعدّد التكليف أو لا يوجب إلّا تكليفاً واحداً؟ فإتيان المكلّف بالفعل ثانياً يكون عزيمة. وعلى الأوّل، فهل يجب الإتيان بما هو قضيّة كلّ جزاء على حدّة، أو يكفي إتيان فعل واحد؟ لو قلنا بأنّه لا مانع من اجتماع الوجوبين في محلّ واحد بعنوانين مختلفين، فلو أتى المكلّف بفعل
ص: 314
واحد بقصد امتثال الجميع يجزيه عن الجميع. ولو أتى بأفعال متعدّدة بقصد امتثال الأوامر المتوجّهة إليه في کلّ جزاء لا مانع منه.
ويعبّر عن الاختلاف الأوّل بأنّ الأصل، أي ظاهر القضیّة، هل يقتضي تداخل الأسباب أو لا؟
وعن الثاني بأنّ الأصل هل يقتضي تداخل المسبّبات أو لا؟
ولا يخفى: أنّه لا مساس لهذه المسألة بالمسألة السابقة كما توهّم في الكفاية؛ لأنّ البحث والاختلاف في المسألة السابقة فيما إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء مع العلم بعدم تعدّد الجزاء، بخلاف هذه المسالة.
وأيضاً محلّ البحث فيما نحن فيه يكون فيما إذا كان الشرط بحسب ظاهر القضیّة سبباً لتعلّق التكليف بالمكلّف، بخلاف المسألة السابقة فإنّ تعلّق التكليف الصلاتي بالمكلّف فيما إذا قال: إذا خفي الأذان... وإذا خفي الجدران... مفروغ منه وإنّما يبيَّن بهما حدّ الانتقال من التمام إلى القصر.
هذا، مضافاً إلى ابتناء المسألة السابقة على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، وعدم ابتناء مسألتنا هذه عليه أصلاً. فلا مساس لکلّ واحدة منهما بالاُخرى.
إنّ المحقّق الخراساني(رحمه الله) قد اختار مذهب المشهور، وهو: عدم التداخل. واستدلّ عليه بأنّ ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه، وذلك يقتضي حدوث الجزاء عند حدوث کلّ من الشرطين.
ولا ريب أنّه مع القول بكون حقيقة واحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل: إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ أو فيما إذا نام مكرّراً لا يمكن أن تكون محكومة
ص: 315
بحكمين متماثلين، يكون مقتضى هذا الظهور فيما إذا تعدّد الشرط كما في المثال هو وجوب الوضوء بکلّ شرط غير ما وجب بالآخر. ولا ضير في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر، وإلّا يلزم رفع اليد عن هذا الظهور.
لا يقال: تقدير تعدّد الفرد ينافي إطلاق الجزاء؛ لأنّ إطلاقه يقضي بوجوب الإتيان بمجرّد وجود الطبيعة من غير تقييد ولو قلنا بأنّ متعلّق الوجوب في کلّ من الجزاءين يكون فرداً من الطبيعة غير ما هو متعلّق الوجوب في الجزاء الآخر، يوجب تقييد إطلاق الجزاء.
فإنّه يقال: إنّ ظهور الجملة في كون الشرط سبباً أو كاشفاً عن السبب يقتضي ذلك، أي تعدّد الفرد، فيكون بياناً لما هو المراد من إطلاق الجزاء.
ولا دور بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور إطلاق الجزاء؛ لأنّ ظهور الإطلاق يكون معلّقاً على عدم البيان، وظهور الجملة فيما ذكر صالح لأن يكون بياناً، فلا ظهور له مع ظهورها.((1))
ثم اعلم: أنّ الشيخ(قدس سره) قد استدلّ على هذا المذهب بظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء وعلّيته له، ومقتضى ذلك كون کلّ علّةٍ علّةً لمعلول مستقلّ.
وبعبارة اُخرى: ظهور الجملة الشرطية في مسبّبية الجزاء للشرط يقتضي كون الجزاء المسبّب معلولاً له بخصوصه، ولازم ذلك كون متعلّق الوجوب في کلّ من الشرطين فرداً من الطبيعة غير الفرد الّذي يكون متعلّق الوجوب في الآخر.((2))
ولا يخفى: أنّ ما أفاد في الكفاية مأخوذ عمّا أفاده الشيخ(رحمه الله) مع تفاوت يسير؛ لأنّ
ص: 316
الشيخ(رحمه الله) استدل بظهور الجملة في علّية الشرط ومعلولية الجزاء، والمحقق الخراساني(رحمه الله) استدلّ بظهورها في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط.
والفرق بين التقريبين: أنّه على ما أفاده في الكفاية إذا قارن وجود أحد الشرطين مع الآخر لا مانع من وحدة الجزاء، ولا يكون هذا رفع اليد عن الظهور؛ لأنّه لا دلالة للجملة - بناءً على ما أفاده - على طلب حدوث کلّ من الشرطين حدوث الجزاء مستقلّا ولو في صورة مقارنة الشرطين، بل إنّما تدل على لزوم حدوث الجزاء عند حدوث الشرط قارن معه شرط آخر أم لا.
وهذا بخلاف ما أفاده الشيخ(رحمه الله)؛ فإنّ مقتضاه حدوث الجزاء مستقلّا عند حدوث کلّ من الشرطين مطلقاً، هذا.
ولا يخفى عليك: أنّ ما أفاده الشيخ(قدس سره) في ضمن كلماته، كما في التقريرات، من أنّ متعلّق الجزاء إذا كان واحداً نوعياً كالوضوء وقلنا بأخذ الوحدة النوعية في الموضوع له، لا يكون قابلاً للتعدّد فلا يتحمّل وجوبين؛ إذ لا فرق في امتناع اجتماع الأمثال بين أن تكون الوحدة شخصية أو نوعية، فعند تعدّد الأسباب لا دليل على تعدّد الآثار والتكاليف، لعدم صلاحية الفعل المتعلّق للتكليف المدلول عليه باللفظ المأخوذ في الجزاء للتعدّد.((1))
ثم منع(قدس سره) دخالة الوحدة النوعية في الموضوع له؛ لأنّ ما هو الموضوع له ليس إلّا نفس الماهية الخارجة عنها الوحدة.((2))
فليس ما أفاده في محلّه؛ لأنّ الواحد النوعي صالح للتعدّد.
ص: 317
وكذا ما أفاد في الجواب عمّا أفاده المحقّق النراقي(رحمه الله) - من أنّ الأسباب الشرعية علل للأحكام المتعلّقة بأفعال المكلّف لا لنفس الأفعال، فتعدّد الأسباب لا يوجب تعدّد المسبّبات وهو الوجوب. ولا دلالة لتعدّد الوجوب على وجوب إيجاد الفعل متعدّداً، لإمكان تعلّق الفردين من حكم بفعل واحد كما في الإفطار بالحرام في نهار شهر رمضان وقتل زيد القاتل المرتدّ - من أنّ المسبّب هو اشتغال الذمّة ولا مانع من قبول الاشتغال للتعدّد؛ لأنّه تابع لقبول الفعل المتعلّق له، فإذا كان الفعل ممّا يقبل التعدّد فالاشتغال به أيضاً يقبل التعدّد.
ليس في محلّه أيضاً؛ لأنّ المسبّب ليس اشتغال الذمّة، بل هو أمر ينتزع من تعلّق التكليف بالمكلّف، كما هو واضح.
هذا، والّذي ينبغي أن يقال في أصل استدلال الشيخ وصاحب الكفاية(قدس سره): إنّه بعد هذه الإفادات، إنّا لم نتعقّل معنىً صحيحاً لتقييد الجزاء ولم يمكن لنا تصوّره؛ لأنّ متعلّق الوجوب إمّا أن يكون في إحدى الجملتين نفس الطبيعة مطلقة ومن غير تقييد، فما معنى تقييد متعلّق الآخر؟ وإن قيل: إنّه مقيّد بما هو غير متعلّق الآخر، فلا يفهم معنى صحيح لتقييد فرد من الطبيعة بكونه غير تلك الطبيعة.
وإمّا أن يكون متعلّق الوجوب فيما يوجد سببه أوّلاً هو فرد من الطبيعة وفي الآخر ما كان غير هذا الفرد، ففيه: أنّه لا يكون في جميع الموارد وجود سبب المقيّد مسبوقاً بوجود سبب غير المقيّد، بل تارة يكون هذا مسبوقاً واُخرى ذاك.
وهكذا الكلام لو قلنا بأنّ كلّا من المتعلّقين مقيّد بأن يكون غير الآخر.
ويمكن أن يكون هذا وجه ما قال بعض الأعاظم من أنّ الشرط إنّما هو سبب للأفعال لا للأحكام، وأمّا الحكم فيجيء من قبل اقتضاء السببية لهذا الفعل.
ص: 318
ولكن هذا غير حاسم لمادّة الإشكال، لأنّ ظاهر القضیّة كون الشرط سبباً للحكم للأفعال.((1))
ص: 319
لا يخفى: أنّه يجب تطابق المفهوم مع المنطوق في تمام القيود المعتبرة في الكلام والإعتبارات اللاحقة إلّا في النفي والإثبات، كما هو واضح لا ريب فيه.
وإنّما الإشكال فيما إذا كان المأخوذ في المنطوق عامّاً استغراقياً، كقولك: «إن جاءك زيد فأكرم العلماء» فهل يكون مفهومه عدم وجوب إكرام کلّ فرد من العلماء في ظرف عدم المجيء، أو عدم وجوب إكرام الجميع؟ فلو دلّ على وجوب إكرام بعضهم لا يعارضه المفهوم.
وبعبارة اُخرى: المفهوم هو عموم السلب أو سلب العموم؟
ولا فرق في ذلك بين أن يكون مفاد المنطوق القضیّة الموجبة أو الشرطية السالبة، كقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «إذا کان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»،((1)) فهل يكون مفهومه أنّه إذا لم يكن قدر كرّ ينجسّه کلّ شيء من النجاسات. أو أنّ مفهومه أنّه إذا لم يكن كراً ينجسّه شيء منها؟ يمكن أن يقال: إنّ الوجه الثاني هو ما يفهم العرف من هذه القضیّة دون الأوّل. فالحقّ ما اختاره الشيخ المحقّق صاحب الحاشية((2)) وإن خالفه المحقّق الأنصاري((3)) قدّس الله سرّهما.
ص: 320
قد ظهر ممّا ذكرنا سابقاً أنّ ما هو ملاك أخذ المفهوم عند القائل به من القدماء: اشتمال الكلام على قيد زائد من جهة أنّ الأصل يقتضي أن لا يكون المتکلّم لاغياً وأن لا يكون صدور الكلام منه لأجل فائدة غير إفادة مراده، فاشتمال الكلام على قيد زائد یدلّ على دخالة هذا الزائد في الحكم. ولازم ذلك انتفاء الحكم وعدم وجوده عند كونه مجرّداً عن قيدٍ مّا. وقد ذكرنا: أنّ المفهوم على قولهم يستفاد من دلالة نفس تکلّمه، بما أنّه فعل من الأفعال. وقد قلنا أيضاً بأنّه لا يستفاد من هذا إلّا دخالة هذا القيد، وأمّا الانتفاء عند الانتفاء مطلقاً ولو قام مقام هذا القيد قيد آخر فلا يستفاد منه، إلّا إذا كان المتکلّم في مقام بيان تمام ما هو المناط للحكم واُحرز ذلك.
ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا كان القيد الزائد الّذي أتى به في كلامه أداة الشرط أو الوصف أو الغاية أو ما يفيد الحصر؛ فإنّ النزاع في جميع ذلك عندهم من وادٍ واحد. كما ينبئ بذلك قول القائل بعدم المفهوم في الجميع بأنّ إتيان المتکلّم بالقيد الزائد ربما يكون لأجل فائدة اُخرى غير دخالة القيد في حكمه.
نعم، ربما يختلفون في بعضها كالغاية، بأنّ ما يستفاد منها - وهو ثبوت الحكم للمغيّى وعدمه في غيره - هل يكون بالدلالة المنطوقية حتى تكون كلمة «حتى» موضوعة لإفادة ذلك، أو يكون بالدلالة المفهومية حتى يكون مفاد المنطوق ثبوت الحكم للمغيّى ودخالته فيه، ومفهومه عدم ثبوت الحكم لغيره؟((1)) ومنشأ توهّم كون ذلك بالدلالة المنطوقية كون «حتّى» وغيره (مثل: إنّما، وإلّا) وضع لذلك المعنى، وأنّ
ص: 321
استفادة انتفاء الحكم عمّا هو خارج عن المغيّى في الغاية وعن المستثنى في الاستثناء من أظهر المفاهيم كما قيل، فتوهّم أنّ ذلك يكون مستفاداً من المنطوق.
ثم لا يذهب عليك: أنّ المحقّق الخراساني(قدس سره) مع أنّه لم يسلك مسلك القدماء أفاد في مفهوم الغاية كلاماً يناسب ما ذهبوا إليه، وهو: أنّ قضية القواعد العربية أنّ الغاية إذا كانت قيداً للحكم كقوله: «كلّ شيء حلال... إلخ» تدلّ على ارتفاع الحكم عند حصولها، وإذا كانت قيداً للموضوع فلا .((1))
تنبيه: ذكر في الكفاية إشكالاً في دلالة كلمة الإخلاص (لا إله إلّا الله) على التوحيد، وهذا نصّه: «أنّ خبر «لا» إمّا يقدّر «ممكن» أو «موجود» وعلى کلّ تقدير لا دلالة لها على التوحيد.
أمّا على الأوّل؛ فإنّه حينئذٍ لا دلالة لها إلّا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده.
وأمّا على الثاني؛ فلأنّها وإن دلّت على وجوده تعالى إلّا أنّه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر».
ثم دفعه: «بأنّ المراد من الإله هو واجب الوجود ونفي ثبوته ووجوده في الخارج وإثبات فرد منه فيه وهو الله یدلّ بالملازمة البيّنة على امتناع تحقّقه في ضمن غيره تبارك وتعالى؛ ضرورة أنّه لو لم يكن ممتنعاً لوجد، لكونه من أفراد الواجب».((2))
ولا يخفى عليك: أنّ أصل الإشكال وجوابه فاسد.
أمّا فساد الجواب؛ فلأنّ مثل هذا العنوان (واجب الوجود) الحادث المصطلح البعيد
ص: 322
عن كثير من الأذهان خصوصاً العرب في ذلك الزمان (زمان بعثة النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لا يكون مدلولاً للكلام الملقى إليهم. والمعنى وإن كان مركوزاً في أذهانهم إلّا أنّه لا ينافي بُعد العنوان المانع عن تقديره في الكلام.
وأمّا فساد الإشكال؛ فلأنّ العرب ما كانوا ينكرون وجود الخالق الباري المنشئ للمخلوقات ولا وحدانيته تعالى، وإنّما كانوا يعبدون من دون الله أصناماً ليقرّبوهم إلى الله زلفى،((1)) مع الاعتراف بأنّها مخلوقة، ولا يعتقد أحد منهم اُلوهية الأصنام، ولذا يأخذهم الله تعالى بإقرارهم ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ...﴾((2)) الآية ووبّخهم على عبادة ما ليس فيه صلاحية العبادة، ومن لا يخلق بل هو يُخلق: ﴿أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً﴾؛((3)) ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾؛((4)) وكلمة التوحيد الطيبة إنّما تفيد نفي کلّ معبود سوى الله تعالى وتثبت التوحيد في العبادة.((5))
ص: 323
ويمكن أن يقال: بعدم الاحتياج إلى تقدير الخبر في هذه الكلمة ونظائرها مثل «لا رجل في الدار» كما يظهر من سيبويه،((1)) وهو الحقّ كما سيجيء إن شاء الله تعالى مزيد توضيح له في بعض مباحث العامّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وهو حسبي ونعم الوكيل في المبدأ والمآل. ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان، وحسِّن نيّاتنا وأعمالنا، واجعلها خالصة لك بحقّ محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
ص: 324
ص: 325
الفصل الأوّل: في أقسام العامّ
الفصل الثاني: في وجود الصيغة للعموم
الفصل الثالث: فيما یدلّ على العموم
الفصل الرابع: في حجّية العامّ المخصَّص
الفصل الخامس: في التمسّك بالعامّ عند إجمال المخصِّص مفهوماً
الفصل السادس: في التمسّك بالعامّ عند إجمال المخصِّص مصداقاً
الفصل السابع: في التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص
الفصل الثامن: شمول الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين
الفصل التاسع: تعقّب العامّ بضمير راجع إلى بعض أفراده
الفصل العاشر: تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف
الفصل الحادي عشر: الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
الفصل الثاني عشر: جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
الفصل الثالث عشر: أحوال العامّ والخاصّ المتخالفين
ص: 326
ص: 327
إنّما عدلنا عن عنوان القوم، وهو: «العامّ والخاصّ» أو «العموم والخصوص»، لئلّا يتوهّم بعض المبتدئين تقابلهما، وأنّ الخاصّ هو كلّ لفظ كان غير العامّ، حتى يكون الجزئي الحقيقي أيضاً خاصّاً.
ولا يخفى: أنّ عدم تقابلهما من الواضحات؛ لأنّهم قد قالوا في تعريف الخاصّ بأنّه ما قصر عن شموله،((1)) فالمتکلّم تارة: يلاحظ تمام ما يصلح له المفهوم ويُلقي اللفظ من غير أن يقصر شموله، واُخرى: يلاحظ ما يصلح له لكن مع تخصّصه بخصوصيته بحيث يقصر شمول المفهوم لتمام ما يصلح له. ففي الحقيقة ينقسم العامّ إلى قسمين: قسم لا يقصر شموله، وقسم قصر عن شموله.
قد عرّفوا العامّ بتعاريف، لا يخلو كلّها عن الإشكال بالانعكاس والاطّراد. ولا مجال لهذه الإشكالات بعد كون هذه التعاريف كلّها لفظية.
فمنها: قولهم في تعريفه: بأنّه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه.((2))
ص: 328
وفيه أوّلاً: أنّ استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له إنّما يكون بملاحظة معناه ومفهومه، لا باعتبار نفس ذاته.
وثانياً: لا ينطبق العامّ، مثل کلّ رجل وغيره، على کلّ فرد من الأفراد الّذي يكون هذا العامّ مستغرقاً له، بل ما ينطبق على الأفراد ليس إلّا لفظ رجل في المثال.
فالأولى: أن يقال في تعريفه: بأنّه اللفظ المستغرق لجميع أفراد مفهوم واحد من حيث المعنى. أو أنّه اللفظ الدالّ على استغراق جميع أفراد مفهوم واحد من غير فرق بين أن يكون اللفظ الدالّ على العموم واحداً كالعلماء - بناءً على مذهب المحقّق الخراساني(رحمه الله) من عدم إفادة الألف واللام العموم - ، أو مرّكباً ككلّ رجل، والجمع المضاف، وغيرهما.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الكلام في المقام يقع في طيّ فصول:
ص: 329
قد ذهب المحقّق الخراساني(رحمه الله) كغيره((1)) إلى انقسام العامّ إلى المجموعيّ والبدليّ والاستغراقيّ. إلّا أنّه أفاد بأنّ انقسامه إليها إنّما يكون من جهة اختلاف كيفية تعلّق الأحكام، وإلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو: شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه.((2))
ولكنّ التحقيق يقتضي خلاف ما أفاده(قدس سره)، وذلك لأنّ المفهوم - مع قطع النظر عن موضوعيته للحكم ولحاظ الحكم - إمّا أن يمتنع فرض صدقه على الكثيرين ولا يتطرّق فيه التكثّر. فهو جزئي، وإمّا يتطرّق فيه ذلك ويمكن تكثير وجوده خارجاً ولا يمتنع فرض صدقه على الكثير، فهو كلّي. فلو لوحظ المفهوم الّذي يكون قابلاً للتكثّر بحسب الوجود بما أنّه كذلك وقابل لتطرّق الكثرة فيه، فهو كلّي باصطلاح المنطقيّين وعامّ منطقيّ باصطلاح الاُصوليّين. ولو لوحظ هذا المفهوم وجعل مرآة للخارج، فلو جعل مرآة وآلة لملاحظة تمام الكثرات على نحو يكون الملحوظ کلّ واحد من أفراده، فهو العامّ الاستغراقي. ولو جعل هذا المفهوم الّذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين
ص: 330
آلة لملاحظة أحد من الأفراد على سبيل الترديد، فهو العامّ البدلي. ولو جعل مرآة لملاحظة تمام الكثرات على نحو يكون الجميع شيئاً واحداً، فهو العامّ المجموعي.
فعلى هذا، تكون الأقسام أربعة: العامّ المنطقي، والمجموعي، والبدلي، والاستغراقي. إلّا أنّه لا فرق بين البدليّ والمنطقي من حيث الحكم، مثل أن يقال: جئني برجل أو بالرجل.
هذا، مضافاً إلى أنّنا نجد من أنفسنا الفرق بين ألفاظ: أحد الرجال، والرجل، ورجل، والرجال ولو لم يتعلّق بها حكم من الأحكام.
ولا يذهب عليك: أنّ العامّ المجموعي بهذا المعنى الدائر في السنّة المتأخّرين قلّما يوجد، بل لم نجده في الشرعيات أن يكون موضوعاً لحكم من الأحكام؛ فإنّ العامّ المجموعي في ألسنتهم ما يكون مركّباً من أفراد مفهوم واحد ولوحظ الجميع شيئاً واحداً، فهو مركّب تكون أجزاؤه متوافقة في الحقيقة. وهذا بخلاف العامّ المجموعي الدائر على ألسنة القدماء؛ لأنّه عندهم مركّب من أجزاء لا توافق بينها بحسب الحقيقة. وقد مثّلوا له بالدار؛((1)) فإنّه مركّب من السقف والجدران وغيرهما من الأجزاء ولا توافق بينها بحسب الحقيقة ولوحظ الجميع شيئاً واحداً. وسيجيء إن شاء الله تعالى أنّ الأحكام الثابتة لجميع أقسام العامّ ثابتة لهذا أيضاً.
ممّا ينبغي ذكره في المقام: أنّ الأصل في ألفاظ العموم كونها للاستغراق؛ وذلك لأنّ الإنسان يلاحظ أوّلاً مفهوماً واحداً كمفهوم الرجل والعالم، ثم يجعل ذلك المفهوم مرآةً لملاحظة ما ينطبق عليه، ولازم هذا ملاحظة تمام أفراد هذا المفهوم على سبيل
ص: 331
الاستغراق؛ لأنّه لا يمكن جعل هذا المفهوم مرآةً لبعض الأفراد أو المجموع من حيث المجموع إلّا مع ملاحظة المفهوم على سبيل الاستغراق، فملاحظتهما محتاج إلى المؤونة الزائدة دون ملاحظته كذلك، كما لا يخفى.
ص: 332
ص: 333
لا يخفى عليك: أنّ من المسائل الّتي ذكرها القدماء في مبحث العامّ والخاصّ واختلفوا فيها وتبعهم المتأخّرون - مع خلوّها عن الفائدة ووضوح أمرها - مسألة: أنّ العموم هل له صيغة تخصّه لغةً وشرعاً أو لا؟
فأثبتها بعضهم، ونفاها بعض آخر.
وربما يستدلّ النافي بتيقّن إرادة الخصوص تارة،((1)) واُخرى بأنّ كون اللفظ حقيقة في الخصوص يوجب تقليل المجاز لاشتهار التخصيص وشيوعه، حتى قيل: ما من عامّ إلّا وقد خصّ. فكون اللفظ موضوعاً للخصوص موجب لتقليل المجاز لا محالة.((2))
أمّا الدليل الأوّل (وهو تيقّن إرادة الخصوص وأولوية جعل اللفظ حقيقة في المتيقّن)، ففيه: إن اُريد من تيقّن إرادة الخصوص إرادة الواضع له، فلا يفهم منه مفهوماً محصّلاً. مضافاً إلى أنّ سبب وضع الألفاظ احتياج أهل المحاورة إلى إفهام المرادات، فكما أنّ الاحتياج يوجب وضع اللفظ في الخصوص كذلك يوجب وضعه في العموم.
ص: 334
وإن اُريد إرادة المتکلّم، فهذا لا يثبت الحقيقة ولا يوجب وضع اللفظ في الخصوص. مضافاً إلى أنّ الخصوص ليس له مفهوم واحد حتى يوضع له اللفظ، إذ الخصوص المراد بقولنا: «أكرم العلماء إلّا زيداً»، غير الخصوص المراد بقولنا: «إلّا عمرواً».
وأمّا الدليل الثاني، ففيه: أنّ كثرة المجاز بعد وضع اللفظ في العموم غير موجبة لوضعه للخصوص إن كان الاستعمال في المعنى المجازي مع القرينة. مضافاً إلى أنّه سيأتي أنّ الاستعمال في الخصوص لا يوجب مجازية الاستعمال، لعدم وجود ملازمة بين التخصيص والمجازية، كما لا يخفى.
وقد ظهر ممّا ذكر: أنّ الحقّ أنّ للعموم صيغاً تخصّه. ولا اعتناء بما ذكره النافي، لما قد أجبنا عنه. والله تعالى أعلم.
ص: 335
ممّا عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم: النكرة في سياق النفي.
واعلم: أنّ دلالتها على العموم ليس من باب وجود وضع مستقلّ لمدخول النفي أو لحرف النفي إذا دخل على النكرة أو اسم الجنس، بل دلالتها على العموم إنّما تكون من جهة أنّ مدخول النفي یدلّ على الطبيعة وحرف النفي على النفي ومن ضمّهما إلى الآخر يستفاد نفي الطبيعة، ونفيها لا يحصل إلّا بنفي جميع أفرادها.
ولا يخفى عليك: أنّ مرادهم بالنكرة في المقام ما يعمّها واسم الجنس، فلو دخل حرف النفي على کلّ منهما يستفاد منه العموم، فلا فرق بين قولنا: «لا رجل في الدار» وبين «ما في الدار رجلٌ» (بالتنوين)، فالأوّل اسم الجنس والثاني النكرة.
كما أنّه لا فرق بين كون المدخول والمنفيّ بسيطاً ومفرداً وكونه مركّباً، فلا فرق بين قولنا: «لا رجل في الدار» وقولنا: «لا رجل موجود في الدار»؛ فإنّ الأوّل بسيط لعدم خبر المدخول، بخلاف الثاني فإنّه مركّب.
والحقّ عدم الحاجة إلى الخبر كما يظهر من سيبويه،((1)) بل هو صحيح من غير تقدير شيء.
ص: 336
لا يقال: كيف يصحّ هذا مع عدم تمامية الكلام؟ لأنّ الكلام مركّب من حرف النفي وهو «لا» واسمه وهو «رجل» فلا يتمّ إلّا مع الخبر.
لأنّه يقال: لا مانع من ذلك ويمكن الالتزام باسمية لفظ «لا» في هذا المورد فلا يكون حرفاً، فيتمّ الكلام.
فإن قلت: لا يمكن تصحيح هذا الكلام مع عدم تقدير لفظ «موجود»، لأنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي، لا موجودة ولا معدومة، فلا يصحّ تعلّق النفي بها في هذه المرتبة، أي في مرتبة ذاتها من حيث هي، فيتعلّق النفي لا محالة بجهة اُخرى غير مرتبة ذاتها، وحيث إنّ أوّل ما يعرض الماهية ليس إلّا الوجود فالنفي لابدّ وأن يتعلّق بالماهية باعتبار وجودها، فلا محيص من تقدير الخبر وهو «موجود» في مثل لا رجل.
قلت: بعد كون الطبيعة من حيث هي لا موجودة ولا معدومة فوجودها كعدمها محتاج إلى العلّة غاية الأمر عدم علّة الوجود يكون علّة لعدمها، وبعد كون الوجود والعدم خارجين عن مرتبة ذاتها، فالنفي والإثبات الواردان عليها لا يردان إلّا على نفسها لا على حيث وجودها؛ لأنّ الوجود خارج عن مرتبة ذاتها، فمعنى قولك: «طبيعة الرجل موجودة»، أو «طبيعة الرجل الموجود موجودة»، أو «طبيعة الرجل معدومة» ليس أنّ طبيعة الرجل الموجود معدومة، بل المراد والمعنى ليس إلّا أنّ الطبيعة بنفسها موجودة أو معدومة. فقولك: «لا رجل في الدار» معناه ليس إلّا أنّ طبيعة الرجل تكون معدومة، لا أنّ طبيعة الرجل الموجود معدومة. وكذا في الفارسية لو قيل: «مرد در خانه نيست» يكون المراد نفي طبيعة الرجل في الدار، لا نفي طبيعة الرجل الموجود في الدار. وكيف كان لا فائدة في ذلك فيما نحن بصدده.
ثم إنّ وجه ما ذكر من أنّ النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم هو: كون الطبيعة موجودة بوجود فردها فانعدامها لا يتحقّق إلّا بانعدام جميع أفرادها، فلا يصحّ
ص: 337
نفي الطبيعة إلّا إذا العدم جميع أفرادها، فلو وجد فرد منها لا يصدق انعدامها، فنفي الطبيعة يفيد العموم لا محالة، ولا يحتاج ذلك إلى شيء أزيد ممّا ذكر.
فما يظهر من المحقّق الخراساني(قدس سره) من أنّ النكرة الواقعة في سياق النفي إنّما تفيد العموم إذا اُخذت مرسلةً، أي مطلقةً، وبنحو الإرسال لا مهملة؛ لأنّ حرف النفي لا يفيد إلّا نفي مدخوله فإن كان مدخول حرف النفي مطلقاً يكون النفي أيضاً مطلقاً، مثل: «لا رجل في الدار» بناءً على استفادة الإطلاق بمقدّمات الحكمة. وإن كان مقيّداً فالنفي أيضاً يكون مقيّداً كما لو قيل: «لا رجل عالماً في الدار» فالنفي يختصّ بالرجل العالم. فعلى هذا، لا يكفي لإفادة العموم مجرّد كون مدخول حرف النفي الطبيعة، لاحتمال أخذ الطبيعة الواقعة في حيّز النفي على نحو الأهمّال لا على نحو الإطلاق والإرسال. فلابدّ من كشف الإطلاق بمقدّمات الحكمة، ثم بعد ذلك الكشف - بمعونة مقدّمات الحكمة - يقال: بأنّ الطبيعة الواقعة في حيّز النفي تكون مطلقة، فتفيد نفي الطبيعة مطلقاً.((1))
ليس في محلّه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في المطلق والمقيّد، وهذا المقام لا يناسب ذكره. والله هو الموفّق والمعين.
ص: 338
ص: 339
ص: 340
لا يخفى عليك: أنّ من أهمّ مطالب البحث في العامّ والخاصّ - الّذي يمكن أن يكون منشأً لإيراد أصل البحث في كتب الاُصوليين - مسألة: حجّية العامّ المخصّص في ما لم يعلم عدم شمول المخصِّص له أو يعلم عدم شموله له، مثل ما إذا تخصص العامّ بخاصّ وقصر عن شموله لجميع أفراده وأخرج الخاصّ بعض أفراد العامّ، فهل يكون العامّ حجّة في الباقي أو لا؟ كما لو قيل: «أكرم العلماء إلّا زيداً» فلا إشكال في خروج زيد عن حكم وجوب الإكرام، وإنّما الإشكال في أنّ هذا العامّ باقٍ على حجّیته لوجوب إكرام العلماء غير زيد، بحيث يؤخذ بالعموم ويحكم بوجوب إكرام جميع العلماء غير زيد أو ليس العامّ حجّة هكذا؟
ومنشأ الإشكال ما قيل: من أنّ حمل اللفظ على المعنى المجازي محتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وقرينة اُخرى معيّنة لكون المراد من اللفظ هو المعنى المجازي، وبعد فرض كون العامّ حقيقة في العموم فاستعماله في الخصوص مجاز فالتخصيص قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وأنّه ليس مراداً للمتكلّم، وأمّا تعيين أنّ اللفظ استعمل في أيّ معنى من المعاني المجازية فلا دلالة للتخصيص عليه، فليس في البين قرينة معيّنة لكون المراد هو هذا المعنى المجازي دون غيره من سائر المعاني
ص: 341
المجازية؛ لأنّ کلّ مرتبة من الباقي بعد التخصيص معنى مجازيّ للمعنى الحقيقي غير مرتبته الاُخرى، فلفظ العامّ الشامل لعشرة أفراد مثلاً استعماله في التسعة مجاز وفي الثمانية مجاز وفي السبعة مجاز وهكذا، وبعد معلومية عدم إرادة الكلّ من لفظ العشرة وخروج واحد من الأفراد عن تحته لا يصحّ حمل اللفظ على معنىً من المعاني المجازية إلّا بمعونة القرينة وهي غير موجودة في المقام.
هذا مضافاً إلى أنّه لو فرضنا وجود قرينة معيّنة لإحدى المراتب، مثلاً: إذا قال: «أكرم العلماء إلّا زيداً» فهم بمعونة القرينة أنّ المراد وجوب إكرام واحد أو إثنين من العلماء، فتعيّن هذا الواحد من بين العلماء بأنّه بكر أو خالد أو غيرهما يحتاج إلى القرينة. وفي صورة كون المراد وجوب إكرام الإثنين فتعيّن أنّهما زيد وعمرو أو زيد وخالد أو غيرهم محتاج إلى القرينة وبدونها لا يمكن ذلك. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الإشكال.
وقد أجاب عنه بعض القدماء بأنّ مقتضى قاعدة: «إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات» تعيّن حمل لفظ العامّ بعد عدم كون المراد منه المعنى الحقيقي على الباقي؛ لأنّ الباقي هو أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي.((1))
وفيه: أنّ ملاك الأقربية بنظر العرف، وليس هذا موجباً للأقربية عندهم.((2))
إذا عرفت ذلك، نقول توضيحاً للمطلب: إنّ التخصيص إمّ-ا يكون بالمتّصل أو بالمنفصل.
والثاني: مثل إذا قال المولى في اليوم الماضي: «أكرم العلماء» ثم قال في هذا اليوم: «لا تكرم الفسّاق منهم» أو «لا تكرم زيداً».
ص: 342
والأوّل: إمّا أن يكون التخصيص فيه بلسان التقييد مثل ما إذا قال: «أكرم کلّ رجل عالم» فتخصيص الرجل بالعالم إنّما وقع بلسان التقييد، وإمّا يكون بلسان الإخراج كما لو قيل: «أكرم العلماء إلّا زيداً».
ففيما ورد التخصيص بالعالم - متّصلاً كان أم منفصلاً - لا إشكال في عدم كون العامّ حجّة فيما اُخرج بدليل التخصيص. وإنّما الكلام في حجّية العامّ في أفراده الباقية، فذهب بعضهم إلى عدم الحجّية مطلقاً، وقد مرّ وجه هذا القول. وذهب بعضهم إلى التفصيل بين المخصّص المتّصل والمنفصل، فقال بحجّيته في الأوّل دون الثاني.((1))
واختار بعضهم حجّیته في تمام الباقي مطلقاً سواء كان التخصيص متّصلاً أو منفصلاً.
وقد أجاب الشيخ(قدس سره) عن الإشكال المتقدّم ذكره: بأنّ دلالة العامّ على کلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده،((2)) فلو قال: «أكرم العلماء» فدلالته على وجوب إكرام زيد العالم لا تكون منوطة بدلالته على وجوب إكرام عمرو العالم. والسرّ في ذلك: أنّ العامّ وإن كان لفظاً واحداً یدلّ على معناه ولكن هذه الدلالة بحسب الدقّة العقلية دلالات، وهذا معنى الانحلال وأنّ دلالة واحدة تنحلّ إلى دلالات عديدة بعدد أفراد العلماء، فليست بحسب الدقّة دلالة بسيطة واحدة، بل إنّما هي دلالات عديدة، ودلالة اللفظ على کلّ واحد من الأفراد ليست منوطة بدلالته على سائر الأفراد. فعلى هذا، لو قصر العامّ عن شموله لبعض الأفراد فلا مانع من شموله للبعض الآخر لما قلنا من أنّ دلالته على البعض غير منوطة بدلالته على سائر الأفراد.
ص: 343
إذا عرفت ذلك في العامّ المخصّص فنقول: بأنّه بعد ورود التخصيص يكون أثر التخصيص قصر دلالة العامّ لشموله لفرد المخصّص، ولكن دلالته على غير هذا الفرد محفوظة على حالها.
فيندفع الإشكال المتقدّم (وهو بعد عدم كون المعنى الحقيقيّ مراداً للمتكلّم يحتاج حمل اللفظ على کلّ واحد من المعاني المجازية إلى القرينة المعيّنة، ولا يكفي مجرّد وجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، لأنّ تعيين مراد المتکلّم من بين المعاني المجازية محتاج إلى قرينة معيّنة وهي غير موجودة في المقام، فيصير لفظ العامّ بعد قيام القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي مجملاً، فتسقط حجّیته في الباقي).
وتوضيحه بأنّه: لو كان المعنى الحقيقي أمراً بسيطاً أو مركّباً يكون شموله لأجزائه بحيثية واحدة وعلى نحو وحدانيّ غير انحلالي، وقامت القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، فيصحّ الإشكال بأنّه لا يمكن حمل العامّ على بعض المراتب أو بعض الأجزاء بمجرّد قيام القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي. وأمّا إن كان المعنى الحقيقي مع كونه واحداً في وحدته منحلّا بالدقّة العقلية إلى كثرات وكانت دلالتها على کلّ من الكثرات باعتبار تعدّد الدلالات، فقيام القرينة على عدم دلالة المعنى الحقيقي على واحدة من هذه الكثرات لا يصير سبباً لعدم دلالته على سائر الكثرات، وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ دلالة العامّ كما قلنا تنحلّ إلى دلالات، وكلّ دلالة لا تتوقّف على دلالة اُخرى، فالقرينة الصارفة وهي التخصيص لا تسبّب إلّا قصر دلالة العامّ عن شموله لهذا الفرد الخارج بسبب التخصيص، وأمّا دلالته على سائر الأفراد فعلى حالها محفوظة.
والحاصل: أنّا لا نسلّم الاحتياج إلى قرينة اُخرى غير القرينة الصارفة لإثبات حجّية العامّ في باقي الأفراد، هذا.
ص: 344
ويظهر من كلامه(قدس سره) - على ما في تقريرات بحثه - تردّده في كون ذلك مجازاً أو حقيقة، بمعنى أنّ العامّ استعمل في صورة التخصيص في المعنى الحقيقي أو المجازي؟((1))
وأورد المحقّق الخراساني(قدس سره) على هذا البيان إيراداً، والظاهر أنّه وارد، وهو: أنّ الظهور إمّا أن يكون بالوضع وهو من موارد استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، وإمّا أن يكون بالقرينة وهو في مورد استعمال اللفظ في المعنى المجازي، فكلّ ظهور لابدّ وأن يكون مستنداً إلى أحدهما، ولا ظهور في غير الموردين. وعليه ففي العامّ المخصّص إن كان الظهور مستنداً إلى الوضع، فأنت تعلم عدم كون العامّ مستعملاً في المعنى الحقيقي وهو الاستيعاب لجميع الأفراد. وإن كان مستنداً إلى القرينة، فكون ظهور العامّ في تمام الباقي لوجود القرينة محلّ إنكار؛ لأنّ التخصيص لا يوجب إلّا صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي، وهذا لا يوجب حصول ظهور للعامّ في تمام الباقي، بل لابدّ من وجود قرينة اُخرى لذلك وهي منتفية، كما لا يخفى.
وأيضاً بعد الاعتراف بعدم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي (وهو استيعابه لجميع الأفراد) لا وجه للترديد في كون هذا الاستعمال حقيقة أو مجازاً.((2))
هذا حاصل ما أفاده الشيخ(قدس سره) وما أورد عليه في الكفاية.
وأمّا صاحب الكفاية فقد أجاب عن الإشكال المذكور: بمنع مجازية العامّ المخصَّص. أمّا في التخصيص بالمتّصل فلا تخصيص أصلاً؛ فإنّ أدوات العموم قد استعملت في العامّ وإن كانت دائرته - سعة وضيقاً - تختلف باختلاف مدخول الأدوات، فلفظة «کلّ» في مثل. «كلّ رجل» أو «کلّ رجل» عالم قد استعملت في العموم وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلّة.
ص: 345
والحاصل: أنّ أدوات العموم تفيد شمول الحكم لجميع أفراد المدخول، وعموميته بحسب الضيق والسعة تابعة للمدخول، فلا يلزم من استعمالها في الخصوص مجازٌ أصلاً.((1))
ويمكن أن يرد عليه: بأنّ هذا الكلام لا يجري فيما إذا كان تخصيص المتّصل بلسان الإخراج، مثل: «أكرم کلّ عالم إلّا زيداً» لأنّ في مثل ذلك تستعمل أداة العموم في غير معناها، حيث إنّ مدخولها - مع قطع النظر عن الاستثناء - لفظ شامل لکلّ عالم حتى زيد، ولفظ الكلّ أيضا دالّ على استيعاب الحكم لجميع الأفراد، والاستثناء يوجب خروج زيد، فليس إخراجه من باب ضيق دائرة مدخول العموم.
ويمكن الذبّ عنه: بأنّ غاية هذا عدم كفاية الجواب المذكور لما إذا خصّص العامّ بالمخصّص المتّصل وكان لسانه الإخراج، فيصير مثل هذا والمخصّص المنفصل من وادٍ واحد، فما به يتفصّى عن المخصّص المنفصل يتفصّى به عن المخصّص المتّصل الّذي لسانه الإخراج. وأمّا عدم كون العامّ مجازاً في صورة التخصيص بالمنفصل، وأنّ استعمال اللفظ في العموم مع هذا التخصيص استعمال في المعنى الحقيقي، فوجهه:
أنّ الإرادة على قسمين: إرادة استعمالية وإرادة جدّية، أمّا الإرادة الاستعمالية فهي عبارة عن: إرادة المتکلّم استعمال اللفظ في معناه من غير أن يكون المعنى مراداً له، وأمّا الإرادة الجدّية فهي عبارة عن: إرادة المتكلم من إلقاء اللفظ كونه قالباً للمعنى، ويكون المعنى مراداً له. ففي المقام لفظ العموم بحسب الإرادة الاستعمالية مستعمل في العموم ولو مع التخصيص، وأثر التخصيص إخراج مورده عن إرادته الجدّية، فنتيجة التخصيص إنّما هي عدم كون الخارج مراداً للمتكلّم، لا أنّ اللفظ قد استعمل في غيره، بل العامّ إذا ورد التخصيص عليه أو لم يرد مستعمل في العموم وهو المعنى
ص: 346
الحقيقي، ولكن بمقدار التخصيص يتصرّف في الإرادة الجدّية بأنّها ليست على طبق الإرادة الاستعمالية.((1))
فإن قلت: فما فائدة هذه الإرادة الاستعمالية في العموم مع العلم بأنّ إرادته الجدّية كذلك.
قلت: قد أفاد في الكفاية جواباً عن هذا الإشكال: بأنّ «من الممكن قطعاً استعمال العامّ في العموم قاعدةً وكون الخاصّ مانعاً عن حجّية ظهوره تحكيماً للنصّ أو الأظهر على الظاهر لا مصادماً لأصل ظهوره».((2))
وأفاد في مجلس الدرس بأنّ فائدة ذلك كون العامّ حجّة للعبد في موارد الشكّ.
فعلى هذا، لا يوجب التخصيص مجازاً في استعمال العامّ أصلاً.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: بأنّ صرف استعمال اللفظ في المعنى لا يوجب أن يصير حجّة للعبد، بل اللفظ لأجل كونه حاكياً عن المعنى وكاشفاً عن مراد المتکلّم يكون حجّة، ومع عدم كون الإرادة الجدّية على طبق الإرادة الاستعمالية كيف يصير مجرّد الإرادة الاستعمالية حجّة للعبد؟
والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ المتکلّم تارة: يستعمل اللفظ في معناه لأجل حضور المعنى في ذهن المخاطب وثبوته وقراره في ذهنه حتى يحكم عليه ويحمل على هذا المعنى ما شاء، وهذا الاستعمال هو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي. واُخرى: يستعمل اللفظ في معناه لكن لا لأجل ثبوت المعنى وقراره في الذهن، بل لأجل أن يلتفت المخاطب إلى معنى آخر، مثل أن قال: «جاء حاتم» وأراد التفات المخاطب إلى أنّ الشخص الجائي متّصف بالجود، إذا كان في مقام المدح، أو أراد التفات المخاطب إلى أنّ هذا الشخص متّصف بغاية البخل، إذا كان في مقام الذمّ، ففي کلّ من الموردين قد
ص: 347
استعمل اللفظ في معناه، لكن لا لأجل أن يثبت في ذهن السامع بل لأجل أن يكون عبرة وطريقاً لانتقاله إلى معنى آخر، وهو كمال جوده أو غاية بخله في المثال.
وهذا الاستعمال مقارن لادّعاء اتّحاد معنى اللفظ مع المعنى الّذي اُريد أن يلتفت إليه المخاطب. ولازم صحّة هذا الاستعمال وجود تناسب بين المعنيين، كما لا يخفى. وهذا هو استعمال اللفظ في المعنى المجازي.
وثالثة: يستعمل اللفظ الواحد الّذي تكون مندرجةً تحته أفراد كثيرة يصدق على جميع هذه الأفراد، لأجل أن يحضر المعنى المندمج فيه تلك الأفراد في ذهن المخاطب، ولكن لا لأجل أن يثبت ذلك المعنى في ذهن المخاطب ولا لأجل أن يلتفت بسببه إلى معنى آخر، بل لأجل أن يحضر المعنى في ذهن المخاطب لكي يتصوّر جميع الأفراد المندمجة فيه. ثم بسبب أدوات الإخراج يخرج ما شاء من هذه الأفراد أو الأجزاء - إذا كان عامّاً مجموعياً - ويبقى الباقي في ذهنه ثابتاً. وهذا الاستعمال يمكن أن يقال بأنّه بين الاستعمال الحقيقي والمجازي ليس مجازاً؛ لأنّ في المجاز يستعمل اللفظ لأن يكون معناه معْبراً وسبباً للالتفات إلى معنى آخر وليس حقيقة؛ لأنّ في الاستعمالات الحقيقية يستعمل اللفظ لأجل حضور المعنى في الذهن وقراره وثباته، وهذا الاستعمال لا يكون كذلك وإن كان أشبه باستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ استعمال العامّ في الخاصّ إنّما يكون من قبيل القسم الثالث. فعلى هذا، لا مانع من الالتزام بصحّة قول الشيخ(قدس سره) إذا كان موافقاً لما ذكرناه في المجاز.
هذا، وقد مضى منّا في علائم الحقيقة والمجاز أنّ عمدة ما عليه الاعتماد في معرفة الحقائق كون المعنى مستفاداً من حاقّ اللفظ من غير أن يتوسّط شيء آخر في البين، وهذا يكون غالب الموافقة مع الاطّراد. وأمّا طريق معرفة المجاز فهو: عدم استفادة المعنى كذلك من اللفظ.
ص: 348
ثم إنّه لا يخفى عليك: أنّه لا فرق في ما ذكر بين العامّ الاستغراقيّ والمجموعي كالدار، كما اُشير إليه. وقد قلنا: إنّ العامّ المجموعي بالمعنى المشهور بين المتأخّرين غير ما هو المذكور في كلام المتقدّمين وأنّ هذا المعنى من العامّ المجموعي بالمعنى المذكور في لسان المتأخّرين لم يوجد في الأحكام الشرعية أصلاً.((1)) هذا تمام الكلام في المقام.
ولا يخفى عليك: أنّ حجّية ظهور العامّ في تمام الباقي من المسلّمات العرفية، فما ذكروه من الإشكال إنّما هو شبهة في مقابل البديهة. والحمد لله ربّ العالمين، ربّ اغفر لنا ولوالدينا يوم يقوم الحساب.
ص: 349
ص: 350
إذا ورد التخصيص على عامّ وكان المخصِّص مجمَلاً بحسب المفهوم، كما إذا كان مفهومه بحسب اللغة غير معلوم، أو كان لفظه من الألفاظ المشتركة، فهل يجوز التمسّك بالعامّ في حكم ما شكّ أنّه من أفراد المخصِّص من جهة إجمال مفهومه أو لا؟
فنقول: الخاصّ المجمل بحسب المفهوم إمّا أن يكون أمره دائراً بين المتباينين، كقولك: «أكرم العلماء إلّا زيداً» مع اشتراكه بين آحاد العامّ. وإمّا أن يكون بين الأقلّ والأكثر، وهو على قسمين: أحدهما: أن يكون الأقلّ داخلاً في الأكثر، كما إذا شكّ في أنّ الفاسق هل هو مرتكب الكبائر أو يعمّه ومرتكب الصغائر؟ وثانيهما: ما لم يكن كذلك ولا يكون الأقلّ داخلاً في الأكثر.
فإذا كان المخصِّص متّصلاً فيسري إجماله إلى العامّ سواء كان إجمال المخصِّص من جهة دورانه بين المتباينين أو الأقلّ والأكثر بقسميه، لعدم انعقاد ظهور للعامّ من أوّل الأمر لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لکلّ واحد من الأقلّ والأكثر أو المتباينين. لكنّ العامّ حجّة فيما عدا مورد الإجمال، والمخصِّص حجّة في الأوّل - إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر - من دون أن يكون العامّ حجّة في الأكثر لفرض إجماله.
وأمّا إذا كان المخصِّص منفصلاً فيسري إجماله إلى العامّ إذا كان أمره دائراً بين
ص: 351
المتباينين أو الأقلّ والأكثر الّذي لم يكن الأقلّ فيه داخلاً تحت الأكثر. وأمّا إذا كان المخصِّص منفصلاً ودار أمره بين الأقلّ والأكثر الّذي كان الأقلّ داخلاً تحت الأكثر فلا يسري إجماله إلى العامّ، بل هو المرجع فيما لم يكن الخاصّ مرجعاً فيه، فتدبّر.
ص: 352
إذا كان المخصِّص مجملاً لا بحسب المفهوم بل بحسب المصداق بأن اشتبه فرد وتردّد بين أن يكون فرداً للعنوان الخاصّ أو باقياً تحت عموم العامّ، فلا إشكال في عدم جواز التمسّك بالعامّ فيما إذا كان المخصّص متّصلاً، لعدم انعقاد ظهور للعامّ من أوّل الأمر إلّا في غير مورد عنوان الخاصّ.
وأمّا إذا كان المخصّص منفصلاً، كما إذا قال المولى: «أكرم كلّ عالم» وقال: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» وشكّ من جهة الاشتباهات الخارجية في أنّ زيداً العالم فاسق أم لا؟
ومحلّ الكلام في ما كان شمول العامّ للفرد المشكوك فرديّته للخاصّ مفروغاً منه، وإلّا فلو كان شمول العامّ للفرد المشكوك فيه مردّداً فلا إشكال في عدم جواز التمسّك بعموم العامّ.
فذهب جماعة إلى عدم جواز التمسّك بعموم العامّ فيما شكّ في مصداقيته للمخصّص.
وجماعة إلى الجواز.
عمدة ما استدلّوا على جواز التمسّك بعموم العامّ ما قالوا: بأنّ مصداقية الفرد المشتبه للعامّ معلومة وبعد ضمّ هذه المقدّمة (وهي اندراج الفرد المشتبه تحت العامّ)
ص: 377
بالكبرى الكلّية المسلّمة وهي: «وجوب إكرام کلّ عالم» نقيم الحجّة على طبق الشكل الأوّل ونقول مثلاً: زيد عالم، وكلّ عالم واجب الإكرام، فزيد واجب الإكرام. وأمّا في طرف المخصِّص فلا يمكن ترتيب ذلك؛ لأنّ محمول الصغرى وهو فاسق في قولنا: «زيد فاسق» غير ثابت، فلا يمكن تشكيل القياس.((1))
وهذا نظير ما قاله الشيخ(رحمه الله) في مبحث أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية من عدم صحّة التمسّك بعموم: «کلّ خمر حرام» لاثبات حرمة هذا المائع المشكوك في أنّه خمر؛ لأنّ إثبات الحرمة محتاج إلى المقدّمتين إحداهما: كون هذا المائع خمرا، والثانية: کلّ خمر واجب الاجتناب، مثلاً، فقال في هذا المورد بجريان البراءة.
وبالجملة: الفرق واضح بين العامّ والخاصّ؛ لأنّ في طرف العامّ مصداقية زيد مثلاً للعنوان المأخوذ في العامّ محرز بالوجدان فبعد ضمّه إلى الكبرى المستفادة من العامّ يتمّ القياس، وأمّا في طرف الخاصّ لا يثبت صدق العنوان المأخوذ فيه على زيد المشكوك فيه بأنّه فاسق أو لا. فتكون الإرادة الجدّية في طرف العامّ بالنسبة إلى الفرد المشتبه مطابقاً وموافقاً للإرادة الاستعمالية كما هو مقتضى الأصل العقلائي وهو أصالة تطابق الإرادة الجدّية مع الإرادة الاستعمالية، وليس لنا دليل على خلاف مقتضى هذا الأصل، كما لا يخفى.
وقد أجاب المحقّق الخراساني(رحمه الله) عن هذا الاستدلال: بأنّ الخاصّ وإن لم يكن دليلاً وحجّة في الفرد المشتبه فعلاً، ولكنه موجب لاختصاص حجّية العامّ في غير عنوان الخاصّ من الأفراد. فعلى هذا، لا يكون «أكرم العلماء» دليلاً وحجّة إلّا في العالم غير الفاسق، فالفرد المشتبه وإن كان مصداقاً للعامّ إلّا أنّه لم يعلم أنّه من مصاديق ما هو حجّة فيه وهو غير الفاسق، أو من مصاديق ما لم يكن حجّة فيه وهو الفاسق.
ص: 353
وبالجملة: العامّ المخصَّص بالمنفصل وإن كان يمتاز عن المتّصل بقيام ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصّصاً، إلّا أنّه في عدم الحجّية - إلّا في غير عنوان الخاصّ - يكون مثل المتّصل، فيكون الفرد المشكوك غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين، فلابدّ من الرجوع إلى الأصل.((1))
ولا يخفى عليك: أنّه يوجه هذا الجواب بأنّ في باب أدلّة الأحكام استفادة الأحكام الكلّية غير مرتبط بالمصاديق والجزئيات، ولا دخالة للمصاديق في حجّية الدليل، مثل قوله: «أكرم العلماء» أو «لا تكرم الفسّاق منهم» لوجوب إكرام کلّ عالم، أو حرمة إكرام کلّ فاسق من العلماء، فالدليل حجّة لثبوت الحكم في موضوعه الكلّي من غير احتياج إلى وجود المصاديق.
وبعبارة اُخرى: حجّية الأدلّة تكون على نحو الكلّية وثبوت الحكم للموضوعات الكلّية، وهذا تمام في مورده. نعم، في مقام إثبات الحكم للأشخاص والمصاديق لابدّ من إحراز مصداقية هذا الشخص لما هو موضوع الحكم حتى يضمّ إلى الكبرى الكلّية المستفادة من الدليل وتؤخذ النتيجة بأنّ هذا الشخص محكومٌ بحكم كذائي.
ولذا وقعت منّا المناقشة في مبحث البراءة مع الشيخ(رحمه الله)، حيث إنّه قال في الرسالة بإجراء البراءة العقلية والشرعية في الشبهات الموضوعية.
ووجه المناقشة: أنّ العقل حاكم بأنّ وظيفة المولى ليس إلّا الأحكام الكلّية فبعد إعمال المولى وظيفته تتمّ حجّته على العبد لو لم يأت بما أمره به، سواء كان ذلك من أجل الاشتباه في الموضوع أو غيره. والسرّ في ذلك: أنّ ما يتلقّى من الشارع - ووظيفته أن يبيّنه ليس إلّا الأحكام الكلية، ومن الواضح أنّ بيانه هذا حجّة لثبوت الحكم - فى الموضوع الكلّي، ولذا لا يصحّ الاعتذار ولا يقبل عذر المكلّف لو خالف أمره في
ص: 354
الشبهة الموضوعية بالنسبة إلى هذا الحكم، ولا يكون عقاب المولى عبده مع بيان ما هو حجّة لهذا الحكم الكلّي عقاباً بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان.
وبالجملة: لا ريب في أنّ حجّية قول الشارع «لا تكرم الفسّاق من العلماء» لحرمة إكرام فسّاقهم على النحو الكلّي تمام ولا نحتاج معها إلى إحراز المصداق. فعلى هذا، نقول في المقام: إنّ «أكرم العلماء»یدلّ على وجوب إكرام کلّ من كان عالماً واقعاً، وقوله: «لا تكرم الفسّاق منهم» يدلّ على عدم وجوب إكرام کلّ من كان منهم فاسقاً، وهذا حجّة على العبد ولو لم يحرز المصداق بعدُ. وأمّا العلم بالمصداق فإنّما يحتاج إليه في مقام إثبات الحكم للمصاديق، لا إثبات أصل الحكم. فعلى هذا، يقصر «لا تكرم الفسّاق» شمول حجّية العامّ وهو «أكرم العلماء» لکلّ من كان فاسقاً واقعاً ويمنع شموله له، فالعام لا يكون حجّة إلّا لوجوب إكرام غير الفاسق من العلماء واقعاً. ففي مورد الشكّ في أنّ هذا فاسق أم ليس بفاسق، لا يصحّ التمسّك بالعامّ؛ لأنّه وإن كان يشمله بظهوره ولكن قد وقع الشكّ في حجّیته في مورد هذا الفرد، لأنّه إن كان فاسقاً لا يكون العامّ حجّة له ودليلاً على وجوب إكرامه، لأنّ المخصِّص قد اختصّ حجّية العامّ في غير الفاسق، كما لا يخفى.
وممّا یدلّ على أنّ حجّية الدليل لإثبات الحكم الكلّي تامّة ولا تحتاج إلى إحراز وجود المصداق: ذهابهم إلى جواز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقية إذا كان في البين أصل موضوعي يحرز به فردية المشتبه للعامّ.
والحاصل: أنّ أدلّة الأحكام الواقعية - وهي الأحكام المتعلّقة بالموضوعات الواقعية - حجّة فيما يستفاد منها من الأحكام الكلّية المتعلّقة بالموضوعات الواقعية، سواء تعلّق بهذه الموضوعات علم العبد أم لا، ولا حاجة في حجّیتها إلى إحراز الصغريات ومصاديق الموضوعات. فأدلّة هذه الأحكام حجّة فيما يستفاد منها كان المصداق
ص: 355
معلوماً أو مشكوكاً. وفائدة حجّیتها كذلك إنّما هي استفادة حكم الصغريات في موارد وجود الاُصول الموضوعية، كما إذا شكّ في فسق زيد بعد عدالته، فإنّ مقتضى دليل: «لا تنقض... إلخ» الحكم بعدالته وترتيب آثارها. فلو لم تكن أدلّة الأحكام الواقعية حجّة لإثبات الحكم الكلّي لا فائدة في إحراز المصداق بالأصل، وتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
فبناءً على هذا، إذا قال المولى: «أكرم العلماء» لا إشكال في تعلّق إرادته الاستعمالية بوجوب إكرام کلّ من كان عالماً واقعاً، والأصل (وهو بناء العقلاء) يقتضي توافق الإرادة الاستعمالية مع الجدّية، ولازم هذا حجية قوله: «أكرم العلماء» لوجوب إكرام کلّ من كان عالماً واقعاً.
ثم إذا ورد من المولى دليل مخصّص لهذه الكلّية - المستفادة من إكرام العلماء - ومبيّن لأنّ الإرادة الاستعمالية ليست طبقاً للإرادة الجدّية، كما إذا قال: «لا تكرم الفسّاق منهم» فلازمه قصر حجّية دليل العامّ على کلّ من كان عالماً غير فاسق واقعاً. لأنّ دليل «لا تكرم الفسّاق منهم» مثل دليل العامّ يفيد عدم وجوب إكرام الفاسق الواقعي منهم على النحو الكلّي، وهو حجّة في ذلك، لأنّ العقلاء يحملون الكلام الصادر من الحكيم على أنّ مراده الاستعمالي هو عين مراده الجدّي، فإذا شكّ في فسق شخص لا يصحّ التمسّك بعموم «أكرم العلماء» لوجوب إكرامه؛ لأنّ حجّیته قد اختصّت بوجوب إكرام کلّ من كان من العلماء غير فاسق واقعاً.
لا يقال: إنّ مقتضى الأصل المذكور - وهو تطابق الإرادتين - في هذا المورد - الّذي شمول العموم له معلوم وشمول المخصِّص مشكوك - جواز التمسّك بالعامّ.
لأنّه يقال: إن اُريد بذلك جواز التمسّك بالعامّ لإثبات وجوب إكرام هذا الشخص واقعاً من جهة الأصل المذكور.
ص: 356
فلا يصحّ؛ لأنّه بعد أن أفاد دليل المخصِّص عدم تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية إلّا إذا كان العالم غير فاسق واقعاً لا مجال للتمسّك بهذا الأصل، وليس بناء العرف والعقلاء على ذلك.
وإن اُريد جواز التمسّك بالعامّ لإثبات وجوب الإكرام ظاهراً، بمعنى أنّه وإن أفاد دليل المخصّص عدم تطابق الإرادتين في العامّ إلّا كذلك، ولكنّ العقلاء في هذه الموارد يتمسّكون بالعامّ لإثبات الحكم للمشكوك، وهو حجّة ظاهراً.
ففيه: أنّ هذا غير معقول بالنسبة إلى دليل واحد، إذ الحكم الظاهري متأخّر عن الواقعي برتبتين، لأنّ الموضوع في الحكم الظاهري هو الشكّ في الحكم الواقعي، فلا يمكن ملاحظتهما معاً، فلا يكون العامّ حجّة لإثبات وجوب الإكرام ظاهراً في هذا المورد.
لا يخفى عليك: أنّه ربما يقال لتصحيح جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية: بأنّ قول القائل: «أكرم العلماء» یدلّ على وجوب إكرام كلّ فرد من العلماء بعمومه الأفرادي، وعلى وجوب إكرام کلّ فرد من أفراد العلماء في جميع الحالات الّتي تفرض له ومن جملتها كونه: مشكوك العدالة والفسق، ومعلوم العدالة، أو الفسق بإطلاقه الأحوالي، فقوله: «لا تكرم الفسّاق منهم» یدلّ على خروج معلوم الفسق من العلماء، وأمّا الباقي فلا يعلم خروجه، فمقتضى أصالة العموم والإطلاق بقاء الفرد المشكوك تحت الحكم.
وفيه: أنّه إن اُريد بذلك أنّ لازم الإطلاق الأحوالي كون کلّ فرد موضوعاً للحكم في حال كونه معلوم العدالة، وفي حال كونه متّصفاً بالصفة الكذائية، وفي حال كونه مشكوك الفسق، حتى يكون کلّ واحد من هذه الحالات جزءاً للموضوع لكي یدلّ العامّ بإطلاقه الأحوالي على وجوب إكرام هذا الفرد في حال كونه مشكوك الفسق ظاهراً؛ لأنّ الحكم الّذي اُخذ في موضوعه الشكّ في الواقع يكون ظاهرياً لا محالة.
ص: 357
فنقول: إنّه توهّم نشأ من الاشتباه في معنى الإطلاق؛ وذلك لأنّ معنى الإطلاق ليس إلّا كون الموضوع المذكور في القضیّة تامّاً في موضوعيته للحكم من غير دخل شيء آخر فيه، بمعنى أنّه كلّما وجد هذا الموضوع فحكمه ليس إلّا هذا، ولا دخالة للحالات في سراية الحكم إلى الفرد، فزيد واجب الإكرام في حال عدالته لكن بما أنّه عالم، وفي حال آخر من حالاته أيضاً بما أنّه عالم. وكذلك إذا قال: «أعتق رقبة» فمعنى الإطلاق فيه كون عتق الرقبة تمام الموضوع للحكم، فعتق هذه الرقبة مثلاً في هذه الحالة مسقط للتكليف لكن لا بما أنّه مقيّد بهذه الحالة ومتّصف بهذه الصفة بل بما أنّه عتق الرقبة فقط، وهكذا عتق هذه الرقبة في حالة اُخرى وهكذا في سائر الحالات. فعلى هذا، لا يكون العالم الّذي شكّ في فسقه واجب الإكرام إلّا بما أنّه عالم لا بما أنّه عالم مشكوك الفسق، فلا يمكن أن يكون الفرد المشكوك فسقه محكوماً بحكم العامّ ظاهراً.
وإن اُريد أنّ الخاصّ إنّما يكون مخرِجاً لبعض الأفراد دون الحالات، فلا تكرم الفساق إنّما يخرَج به من تحت العامّ من كان معلوم الفسق من العلماء، وأمّا من شكّ في فسقه منهم فيثبت وجوب إكرامه بالإطلاق الأحوالي؛ لأنّ أصالة تطابق الإرادتين إنّما اُخذت منّا لأجل دليل المخصِّص بالنسبة إلى الأفراد المعلومة الفسق وأمّا في مورد مشكوك الفسق فحجّيتهما باقية على حالها.
فنقول: بعدما ذكرنا من أنّ مفاد دليل المخصِّص هو عدم وجوب إكرام الفاسق الواقعي من العلماء، وأنّ لازمه قصر حجّية العامّ في وجوب إكرام العالم على غير الفاسق الواقعي؛ لا يبقى مجال لهذا البيان، لأنّ مقتضى دليل التخصيص عدم وجود أصالة التطابق بين الإرادتين إلّا في العالم غير الفاسق الواقعي، فما لم يعلم عدالته وفسقه لا يشمله العامّ بما أنّه حجّة.
وبعبارة اُخرى: التمسّك بالإطلاق الأحوالي فرع كون الفرد تحت عموم العامّ وهو العالم غير الفاسق الواقعي، وكون هذا الفرد تحت هذا العموم مشكوك.
ص: 358
وملخّص الكلام: أنّ قوله: «أكرم العلماء» یدلّ بضميمة أصالة تطابق الإرادة الجدّية مع الاستعمالية على أنّ مراده الجدّي إنّما يكون إكرام کلّ فرد من العلماء، فإذا ورد: «لا تكرم الفسّاق منهم» لا يبقى مجال لإجراء هذا الأصل مطلقاً، ولا يبقى هذا الأصل على حاله محفوظاً إلّا في کلّ من كان عالماً غير فاسق بحسب الواقع. فعليه إذا شكّ في فسق عالم، لا يصحّ التمسّك بعموم أكرم العلماء على وجوب إكرامه؛ لأنّه إنّما دلّ على وجوب إكرام العلماء إذا كانوا بحسب الواقع غير متّصفين بالفسق، وهذا الفرد لا يعلم كونه كذلك.
لا يقال: هذا صحيح، ولكن هذا الفرد حيث لا يشمله دليل المخصِّص ولا يكون حجّة على عدم وجوب إكرامه فيشمله العامّ؛ لأنّ كونه تحت العامّ ليس محلّ الإنكار، وتخصيصه بهذا الفرد منتفٍ بالأصل، فلا يكون مانعاً فيه من التمسّك بعموم العامّ.
فإنّه يقال: بعدما عرفت من أنّ دليل المخصص قد قصّر حجّية العامّ واختصّها بکلّ ما هو فرد للعالم غير الفاسق بحسب الواقع، لا يبقى مجال للقول بشمول العامّ لهذا الفرد، وأنّه حجّة لوجوب إكرامه.
وإن قلت: إنّ العامّ يشمله بما هو مشكوك الحال وفي مقام الظاهر.
فنقول: لا يمكن أن يكون مبيّناً لحكمين يكون أحدهما متقدّماً على الآخر والآخر متأخّراً عنه.
الأوّل: ما أفاده بعض أساتذتنا(قدس سره)،((1)) وهو: أنّ التمسّك بعموم العامّ إنّما يجوز فيما إذا كان عدم التمسّك موجباً لمزيد تخصيص في العامّ، أمّا إذا لم يكن موجباً لذلك
ص: 359
فلا. وهذا كما فيما نحن فيه؛ لأنّ العامّ وهو قوله: «أكرم العلماء»، مخصّص بقوله: «لا تكرم الفسّاق منهم»، فلو شكّ في فرد أنّه من الفسّاق أو لا؟ لا يستلزم عدم التمسّك بعموم أكرم العلماء تخصيصاً زائدا فيه، لأنّه خارج عن تحت العامّ لو كان من الفسّاق بنفس العنوان.((1))
الثاني: قال في مطارح الأنظار (في مبحث العموم والخصوص في الهداية الثانية) تقريراً لما أفاده الشيخ(قدس سره): إنّ منشأ الشكّ في الشبهة الموضوعية هو التردّد في الاُمور الخارجية الّتي لا مدخل لإرادة المتكلّم فيها بوجه، بل ذلك التردّد والاشتباه كثيراً ما يقع للمتكلّم أيضاً، بل قد يقطع المتکلّم بخلاف ما هو الواقع فى المصاديق أيضاً، فمن حاول رفع هذه الشبهة فلابدّ من رجوعه إلى ما هو المعد في الواقع لإزالة هذه الشكوك والشبهات من إخبار وتجربة وإحساس ونحوها. وما يمكن رفعه بالرجوع إلى العامّ هو الشكّ فى مراد المتکلّم على وجه لو صرّح بمراده بعد الرجوع إليه لم يقع الشكّ فيه. ففيما إذا شكّ في أنّ زيداً عادل لو راجعنا المتکلّم أيضاً لا يرتفع الشكّ المذكور، من حيث هو متكلّم، فلا وجه لتحكيم العامّ في مورد الشكّ... إلخ.((2))
هذا تمام كلامنا فيما إذا كان المخصِّص لفظياً.
ص: 360
أمّا الكلام في المخصّص اللبّي، قد أفاد في الكفاية: أنّه إن كان ممّا يصحّ
ص: 361
الاتّكال عليه عند التكلّم - إذا كان المتکلّم بصدد البيان في مقام التخاطب - فهو كالمتّصل؛ لأنّه لا ينعقد للعامّ ظهور إلّا في الخصوص. وإن لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العامّ في المصداق المشتبه على حجّیته، فلابدّ من اتّباعه ما لم يقطع بخلافه.
وقال في مقام الاستدلال على ذلك: بأنّ المولى إذا قال: «أكرم جيراني» وقطع العبد بأنّه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم، كان أصالة العموم باقية بالنسبة إلى من لم يعلم خروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته لعدم حجّة اُخرى بدون ذلك على خلافه. بخلاف ما إذا كان المخصّص لفظياً؛ فإنّ قضيّة تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كأنّه كان من رأس لا يعمّ الخاصّ، كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاصّ متّصلاً. والقطع بعدم إرادة العدوّ لا يوجب انقطاع حجّیته إلّا فيما قطع أنّه عدوّه لا فيما شكّ فيه، كما يظهر صدق هذا من صحّة مؤاخدة المولى لو لم يكرم واحداً من جيرانه لاحتمال عداوته له، وحسن عقوبته على مخالفته، وعدم صحّة الاعتذار عنه، كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء الّتي هي ملاك حجّية أصالة الظهور.
وبالجملة: كان بناء العقلاء على حجّیتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا، بخلاف هناك.((1))
وفيه: أنّه لا فرق في المخصّص اللفظي والمخصّص اللبّي فيما هو ملاك الإشكال وعدم صحّة الرجوع إلى العامّ إذا كانت الشبهة في المصداق؛ لأنّه بعد یرید اکرام من کان عودا له من جیرانه نقطع بان ارادته الجدیه انما تعلقت باکرام من
ص: 362
كان من جيرانه غير عدوّ له واقعاً، فإذا شكّ في أنّ زيداً هل يكون عدوّاً للمولى حتى لا يجب إكرامه أو لا يكون عدوّه حتى يجب إكرامه؟ لا يجوز التمسّك بعموم «أكرم کلّ جيراني» لإثبات وجوب إكرامه، وإلّا يلزم أن يكون العامّ الّذي يكون متكفّلاً لبيان الحكم الواقعي متكفّلاً لبيان الحكم الظاهري أيضاً وهو حكم الفرد المشكوك عداوته، وقد مرّ عدم إمكان بيان الحكم الظاهري والواقعي معاً في خطاب واحد.
ثم إنّه قد ظهر لك: أنّ المحقّق الخراساني(قدس سره) إنّما فصّل بين المخصّص اللفظي واللبّي.
ولكنّ الشيخ(قدس سره) - كما يظهر من تقريرات بحثه - يفصل بين ما إذا علم تخصيص العامّ بما فرض له عنوان وبأنّ الوجه فيه عدم جواز التمسّك بعموم العامّ في الشبهات المصداقية، وبين ما إذا علم تخصيص العامّ بما لم يؤخذ عنواناً في موضوع الحكم، فالحقّ صحّة التعويل عليه عند الشكّ في فرد أنّه من أيّهما.
وقال: إنّ أغلب ما يكون من القسم الأوّل إنّما هو في التخصيصات اللفظية، والثاني أغلب ما يكون إنّما هو في التخصيصات اللبّية.((1))
ولا يخفى ما في هذا الكلام أيضاً؛ لأنّ مورد النزاع في الشبهة المصداقية لا يكون إلّا إذا كان التخصيص بعنوان من العناوين، وإلّا فلو لم يكن تخصيص العامّ بعنوان مأخوذ فى موضوع الحكم فليس من محل النزاع بشيء؛ لأنّه على ذلك يكون المخصَّص وما خرج من تحت العموم فرداً خاصّاً، فلو شكّ في خروج غيره عن تحت العامّ ينتفي خروجه بأصالة عدم تخصيص الأكثر.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في تنبيهات المسألة ما يمكن أن يكون كلام الشيخ(قدس سره) راجعاً إليه.((2))
ص: 363
هذا، ولقائل أن يقول: إنّه يمكن أن يكون اتّكال المولى - إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب - على حكم العقل في الموضوعات الخارجية، ولا يكون اتّكاله على الحكم الكلي، مثلاً إذا قال: «أكرم جيراني» لا يتّكل على الحكم الكلّي الّذي يكون للعقل - وهو عدم وجوب إكرام کلّ من كان عدوّه من جيرانه - حتى يقال بأنّه إذا شكّ في فرد أنّه عدوّه أم لا، لا يصحّ التمسّك بالعامّ من جهة معلومية عدم تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية في من كان عدوّه واقعاً وتطابقهما فيمن كان غير عدوّه واقعاً ولو كان إحراز هذا التطابق بالأصل.
وإنّما يتّكل في قوله: «أكرم جيراني» على حكم العقل في كلّ مورد يحرز بالوجدان مصداقيته للمخصّص من جهة ضمّ هذه الصغرى الوجدانية - وهي أنّ هذا عدوّ للمولى - إلى الكبرى الكلية - وهي كلّ من كان عدوه لا يجب إكرامه - فيحكم العقل بأنّ هذا لا يجب إكرامه، وكذلك في سائر الموارد.
واتّكاله على الأحكام الجزئية دون الحكم الكلّي الّذي للعقل إنّما يكون من جهة أنّه يرى لو اتّكل في مقام بيان الحكم على الحكم الكلّي لا يكون العامّ حجّة للمكلّف في موارد الشكّ، وبسبب هذا ربما يضيّع إكرام كثير من جيرانه مع أنّهم ليسوا بأعدائه، فلأجل أن يكرم المكلّف جميع من تعلّق إرادته الواقعية بإكرامه، حتى المشكوك كونه عدواً له، يلقي العامّ ويتّكل على هذه الأحكام الجزئية العقلية، فيكون الخارج عن تحت العامّ کلّ فرد كانت عداوته معه معلومة، فيكون العامّ حجّة في الفرد المشكوك ويجب إكرامه ظاهراً أيضاً، لكن لا بما أنّه مشكوك بل لأجل مصلحة عدم فوت إكرام الجار الّذي لا يكون عدواً له، فيكون في المقام حكم واقعي وهو: وجوب إكرام کلّ من كان من جيرانه وليس بأعدائه، وحكم ظاهري راجع إلى: وجوب إكرام الفرد الّذي شكّ في عداوته، وحكم واقعي عقلي وهو: عدم وجوب إكرام الجار الّذي تكون عداوته معلومة، وهذا الحكم هو الحكم الّذي اتّكل عليه المولى في مقام البيان.
ص: 364
فبناءً على هذا، لا مانع من التمسّك بالعامّ إذا شكّ في عداوة فرد. ولا يرد عليه الإشكال المتقدّم (وهو عدم إمكان بيان الحكم الواقعي والظاهري بخطاب واحد)، لأنّ هذا لا يمكن إن كان الشكّ في الواقع مأخوذاً في موضوع الحكم الظاهري، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل.((1))
التنبيه الأوّل: في إخراج الأفراد بالتعليل المذكور
إذا قال المولى: «أكرم جيراني» وقال: «لا تكرم زيداً لأنّه عدوّي» والحال أنّ زيداً يكون جاره، وشكّ في أنّ عمرواً عدوّه أم لا؟ فهل يكون التمسّك بعموم «أكرم جيراني» كالتمسّك بعموم «أكرم العلماء» المخصّص بقوله «لا تكرم الفسّاق منهم» إذا شكّ في فسق فرد، من جهة استفادة التعميم من العلّة المذكورة (لأنّه عدوّي) للحكم بالنسبة إلى جميع الموارد، أو نقول بجواز التمسّك بالعموم من جهة أنّ المخصّص إنّما هو في مورد خاصّ وليس مقدار عموم علّته معلوماً؟ وجهان. لا يبعد أن يكون الأظهر هو الثاني من جهة عدم معلومية مقدار عمومية العلّة المذكورة.((2))
ص: 365
التنبيه الثاني: في التمسّك بأحد العامّين المتزاحمين
إذا قال المولى: «أكرم کلّ عالم» وقال في خطاب آخر: «لا تكرم الفسّاق» لا ريب في أنّ مفاد کلّ من الدليلين ثبوت الحكم في ظرف وجود الموضوع، وهو العالم في المثال الأوّل، والفاسق في المثال الثاني. فإن تصادقا كلاهما في مورد واحد ووقع التزاحم بينهما، فلابدّ من ترجيح أحد المقتضيين، إمّا مقتضي الوجوب لو علمنا بأهمّيته في نظر المولى، أو الحرمة لو علم أهمّيتها.
وأمّا إذا شكّ فى صدق أحد العنوانين على فرد يصدق عليه العنوان الآخر، إمّا من جهة أصل الشكّ في وقوع التصادق بين العنوانين خارجاً، أو من جهة الشكّ في مورد خاصّ بعد فرض وجود التصادق في مورد آخر، فهل يكون هذا أيضاً من الشبهة المصداقية حتى لا يصحّ التمسّك بالعامّ من جهة إحراز عدم تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدّية في مورد التصادق بالنسبة إلى العامّ الّذي لا يكون مقتضى حكمه أهمّ من الآخر، أو يجوز التمسّك به؟ فإذا علم صدق عنوان العالم على هذا الشخص وشكّ في صدق الفاسق عليه، فهل لا يجوز التمسّك بعموم أكرم العلماء لإثبات وجوب إكرامه، أو لا مانع من التمسّك به لإحراز وجود المقتضي وعدم إحراز المزاحم؟ لا يبعد أيضاً أن يكون الأوجه هو الوجه الثاني. ألا ترى أنّ العقلاء يذمّون من خالف أمر المولى أو نهيه بعذر وجود هذه الشبهة .((1))
ص: 366
ثم إنّه يمكن أن يكون مراد الشيخ(رحمه الله) عمّا إذا لم يكن للمخصّص عنوان((1)) هو هذا؛ لأنّه ليس للمخصّص عنوان. ويمكن أن يكون مراده ما ذكرناه في التنبيه الأوّل.((2))
التنبيه الثالث: في إحراز المصداقية بالأصل
لا يخفى: أنّ ما قلناه من عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقية سواء كان المخصّص لفظياً أو لبّياً، أو إذا كان المخصّص لفظياً دون ما كان لبّياً كما مرّ، إنّما يكون فيما لم يكن في المورد المشكوك أصل أو أمارة يرتفع بأحدهما الاشتباه، كما إذا قال: «أكرم العلماء» وقال: «لا تكرم الفسّاق منهم» وشكّ في فسق زيد العالم بعد العلم بعدالته سابقاً فباستصحاب العدالة يثبت له حكم العامّ، وذلك مثل ما إذا قامت البينة عليها. كما أنّ قيام البيّنة على فسقه أو جريان استصحاب فسقه موجب لإثبات حكم دليل المخصّص.
وهذا ليس تمسّكاً بالعامّ في الحقيقة بل يكون تمسّكاً بدليل حجّية الأصل أو الأمارة، ومقتضاه وجوب ترتّب آثار مؤدّاهما عليهما وهو في المقام حكم العامّ، وهذا لا إشكال فيه.
إنّما الإشكال فيما إذا لم تكن للمشتبه مع حفظ وجوده حالة سابقة حتى تستصحب، فقد ذهب بعض إلى إمكان إثبات حكم العامّ بتقريبين:
أحدهما: إجراء الأصل، وهو استصحاب العدم المحمولي بالنسبة إلى المخصّص.
بيان ذلك: أنّ العامّ إنّما يؤثّر ويوجب الحكم بعنوانه لا من جهة اُخرى، فإذا فرض
ص: 367
إخراج بعض أفراده عن تحته يكون شموله واقتضاؤه للحكم على حاله بالنسبة إلى الباقي، وشمول العامّ للباقي لا يكون لأجل تخصّصه بخصوصية أو تحيّثه بحيثيات، بل إنّما يشمله حكمه لمجرّد شمول العامّ له، فإذا استصحبنا عدم المخصّص الأزلي في مورد مشكوك فيه فلا مانع حينئذٍ من التمسّك بالعامّ. فعلى هذا، إذا كان لنا عامّ مثل: «المرأة ترى الدم إلى خمسين»((1)) وكان لنا خاصّ وهو: «أنّ القرشية ترى الدم إلى ستّين»،((2)) ثم شكّ في امرأة أنّها قرشية أم لا، فهي وإن كانت إذا وجدت وجدت إمّا قرشية أو غيرها، ولا أصل يحرز بسببه أنّها قرشية أو غيرها، فلا يصحّ استصحاب عدم كونها منتسبة إلى قريش بالعدم الرابط وما هو مفاد ليس الناقصة الّتي تقع في الجواب عن الهلّية المركّبة، إلّا أنّ استصحابه بالعدم المحمولي وما هو مفاد ليس التامّة الّتي تقع في الجواب عن الهلّية البسيطة يجدي في إحراز أنّها ممّن لا تحيض بعد الخمسين؛ لأنّ المرأة الّتي لا تكون بينها وبين قريش انتساب تكون باقيةً تحت العامّ ويشملها العامّ بعنوانه، لا بما أنّها امرأة غير متصفة بالقرشية. فعلى هذا، نقول: إنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بين هذه المرأة والقريش يجدي في تنقيح أنّها ممّن لا تحيض بعد الخمسين.
لا يقال: إنّ هذا الأصل يكون مثبتاً؛ لأنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بالعدم الأزلي لا تثبت كون هذه المرأة غير قرشية إلّا على القول بالأصل المثبت.
لأنّه يقال: قد قلنا بأنّ شمول حكم العامّ لجميع أفراده ليس ملاكه إلّا عنوان العامّ، ولا يكون ملاكه الخصوصيات المختلفة الّتي تكون في الأفراد، ولكن خروج الخاصّ
ص: 368
إنّما يكون بخصوصية خاصّة، فإذا اُحرز عدم وجود هذه الخصوصية فلا مانع حينئذٍ من التمسّك بالعامّ.
وثانيهما: جواز التمسّك بعموم العامّ بإجراء الاستصحاب في العدم النعتي وما هو مفاد «ليس» الناقصة والواقع في الجواب عن الهلّية المركّبة، فنقول: إنّ هذه المرأة لم تكن قرشية سابقاً ولو قبل وجودها، فيستصحب عدم كونها قرشية.((1))
فإن قلت: إنّ الحكم بعدم كونها قرشية بالعدم الرابط في الزمان السابق إنّما يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، والحكم بعدمها قرشية في حال وجودها يكون من السالبة بانتفاء المحمول، فيختلف موضوع القضیّة المشكوكة مع المتيقّنة؛ لأنّ الموضوع في القضیّة المتيقّنة يكون عدم وجود الصفة القرشية للمرأة المعدومة، وفي القضیّة المشكوكة يكون عدم وجود هذه الصفة للمرأة الموجودة.
قلت: لا ضير في ذلك؛ لأنّ المنطقيّين إنّما قسّموا القضیّة إلى الموجبة والسالبة إلّا أنّ القضیّة السلبية أعمّ من كون السلب فيها بالموضوع أو المحمول ليست قضيتين، فالمتيقّن هو عدم قرشيتها قبل وجودها والمشكوك فيه قرشيتها بعد وجودها فيستصحب عدم قرشيتها بعد وجودها وإن كان عدم قرشيتها قبل وجودها يكون من السالبة بانتفاء الموضوع وبعد وجودها من السالبة بانتقاء المحمول، إلّا أنّ ذلك لا يضرّ بصحّة الاستصحاب عند العرف، هذا.
وبعد ذلك كلّه لا يخفى عليك: أنّ المعتبر في الاستصحاب وجود القضية المتيقّنة، ونفي القرشية عن المرأة والحكم بعدم كونها قرشية إذا لم تكن موجودة يتوقّف عند العرف على وجودها حتى يجوز الإشارة إليها بهذه، لا يشار إلى المرأة المعدومة ب-
ص: 369
«هذه»، ولا يرى العرف هنا وحدة بين القضیّة المتيقّنة والمشكوكة.
وبالجملة: أدلّة الاستصحاب منصرفة عن ذلك عند العرف، ولا يكون عندهم ترك المرأة - الّتي ترى الدم بعد الخمسين - أعمال المستحاضة من نقض اليقين بالشكّ، والعرف لا يعتبر هذه المرأة قبل وجودها منتسبة إلى قريش ولا يوصفها نفياً أو إثباتاً بها.
ثم إنّه لا يخفى عليك: أنّ عبارة المحقّق الخراساني(رحمه الله) في المقام، وهي قوله: «إيقاظ: لا يخفى أنّ الباقي تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتّصل لمّا كان غير معنون بعنوان خاصّ بل بکلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلّا ما شذّ ممكناً، فبذلك يحكم عليه بحكم العامّ... إلخ»،((1)) ربما كانت موهمة خلاف المقصود؛ لأنّ ظاهر هذا الكلام أنّ العامّ بعد التخصيص غير باقٍ لموضوعيته للحكم بل إنّما يكون موضوعاً للحكم مع کلّ عنوان يكون غير عنوان الخاصّ على نحو يكون کلّ واحد من العناوين المختلفة جزءًا لموضوع حكم العام، وهذا ممّا لا يقول به أحد.
بل مراده(رحمه الله) أنّ عنوان العامّ باقٍ على موضوعيته في غير المخصّص، فنحن لا نحتاج في مقام إثبات حكم العامّ إلّا إلى إحراز كون المشكوك تحت العامّ وهو محرز بالوجدان، وإلى إحراز عدم وجود عنوان المخصِّص وهو محرز بالأصل، فلا يصير عنوان العامّ مقيّداً بقيد حتى نحتاج لنفيه إلى استصحاب العدم النعتي والسلب الرابط المفقود في المقام، ويكون استصحاب العدم الأزلي بالنسبة إلى عنوان المخصِّص لإثبات موضوع حكم العامّ مثبتاً. بل موضوعية العامّ للحكم باقيةٌ على حالها وإنّما أخرج دليل المخصِّص عنوان الخاصّ، فبعد إثبات انتفائه ولو باستصحاب العدم المحمولي لا مانع من الرجوع إلى العامّ، هذا.
ص: 370
وقد استشكل عليه بعض أعاظم المعاصرين((1)) بقوله: «إنّ جريان هذا الأصل إنّما يتمّ بناءً على توهّم إجراء حكم التقييد على التخصيص، وأنّ المخصِّص يقلّب العامّ عن تمام الموضوعية إلى جزئه، وإلّا فبناءً على المختار، من أنّ باب التخصيص غير مرتبط بباب التقييد، وإنّما يكون شأن المخصِّص إخراج الفرد الخاصّ مع بقاء العامّ على تمامية موضوعه بالإضافة إلى البقية بلا انقلاب في العامّ، نظير صورة موت الفرد، فلا يبقى مجال لجريان الأصل المذكور؛ إذ الأصل السلبي ليس شأنه إلّا نفي حكم الخاصّ عنه لا إثبات حكم العامّ ، لأنّ هذا الفرد حينئذٍ مورد العلم الإجمالي بكونه محكوماً بحكم الخاصّ أو محكوماً - بلا تغيير عنوان - بحكم العامّ، ونفي أحد الحكمين بالأصل لا يثبت الآخر، كما هو ظاهر.
نعم، في مثل الشكّ في مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب أمكن دعوى أنّه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمخالفة الّذي كان أمر رفعه بيد المولى، وفي مثله لا بأس بالتمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية من دون احتياج في مثله إلى الأصل. ولعلّ بناء المشهور أيضاً في تمسّكهم بالعامّ في الشبهة المصداقية مختصّ بأمثال المورد. وعليك بالتتبّع في كلماتهم ربما ترى ما ذكرنا حقيقاً بالقبول وهو الغاية المأمول». انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه: أنّ العامّ بعد تخصيصه لا يعقل أن يكون تامّاً في الموضوعية، فلابدّ وأن يكون العامّ بعد التخصيص مقيّداً بقيد وجوديّ إذا كان عنوان المخصِّص عدميّاً، وبقيد عدميّ إذا كان عنوان المخصِّص أمراً وجودياً. وتقييده بهذا القيد يكون في الأوّل على نحو الوجود الرابط والنعتي، وفي الثاني بنحو السلب الرابط والعدم النعتي. فلا يفيد لإثبات حكم العامّ استصحاب العدم الأزلي، كما زعمه المحقّق الخراساني(قدس سره)؛ لأنّ أصالة عدم انتساب هذه المرأة إلى قريش على نحو العدم المحمولي لا يثبت عدم كون هذه المرأة بقرشية على نحو العدم النعتي، والحال أنّ
ص: 371
العامّ إنّما يكون موضوع حكمه مقيّداً بعدم كونها منتسبة إلى قريش على نحو العدم النعتي.
لا يقال: إنّ معنى هذا دخول باب التخصيص في باب التقييد.
لأنّه يقال: إنّ هذا لا يوجب إجراء حكم التقييد على التخصيص؛ لأنّ الكلام الملقى من المولى عامّ بالنسبة إلى جميع أفراده، بمعنى أنّه لاحظ جميع أفراد العامّ وموضوعية کلّ منها للحكم، ثم أخرج بالدليل المخصِّص بعض الأفراد، فالباقي إنّما يكون تحت العامّ من جهة كونه تمام موضوع الحكم بحسب الإرادة الاستعمالية، ولا يصير إخراج فرد سبباً لتعنون العامّ وتقيّده بقيد كنقيض المخصِّص في المثال المذكور حتى يكون الموضوع عنوان العامّ وذلك القيد. نعم، إخراج الخاصّ موجب لتقيّد موضوع الحكم واقعاً وبحسب الإرادة الجدّية، وهذا إنّما يكون على خلاف باب التقييد؛ فإنّ فيه يكون تمام الموضوع بعد التقييد مقيّداً بقيد عدميّ أو وجوديّ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فلابدّ لنا من القول بتقييد الموضوع في المقام؛ لأنّ ذلك لازم باب التعارض، بخلاف باب التزاحم، كما إذا قال: «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق»، فإنّ فيه في مقام الثبوت أيضاً لا نقول بالتقييد، لأنّ التزاحم إنّما يكون في صورة فعلية المقتضيين، وإنّما نقول بالأخذ بالأهمّ إذا كان في البين، أو التخيير من جهة كون المرجع فيه العقل، وهذا لا يوجب تقييداً في عالم الثبوت أصلاً، كما لا يخفى.
التنبيه الرابع: التمسّك بعمومات العناوين الثانوية((1))
لا يخفى أنّه لا مجال للتمسّك بالعمومات فيما إذا شكّ في فرد لا من جهة
ص: 372
التخصيص بل من جهة اُخرى، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فلا مجال لاستكشاف الصحّة بعموم مثل: «أوفوا بالنذور»((1)) فيما إذا وقع متعلّقاً للنذر، بأن يقال: وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاءً للنذر للعموم، وكلّ ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاً، للقطع بأنّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به.
ولا يخفى عليك: أنّ الشبهة في المقام ليس من جهة احتمال التخصيص لعدم ورود تخصيص على عموم «أوفوا بالنذر» وليس قوله: «لا نذر إلّا في طاعة الله تعالى».((2)) تخصيصاً له، بل إنّما هو تقييد لموضوع الحكم بلسان الحكومة لا إخراج النذر الّذي ليس في طاعة الله. فعلى هذا، يكون الشكّ في صحّة الوضوء بالمائع المضاف في هذا المثال من قبيل الشبهة المصداقية للعامّ، ولم يقل أحد بجواز التمسّك بعموم العامّ - في الشبهة المصداقية لنفس العامّ - وإن ذهب بعضهم إلى جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية المعروفة - ووجهه: استحالة كون الحكم مثبتاً لموضوعه ومكفّلاً لبيانه، وهذا واضح.
وأمّا تأييد هذا بما ورد من صحّة الإحرام قبل الميقات((3)) وصحّة الصوم في السفر.((4))
ففيه: أنّه لا إشكال في ذلك - ولو قلنا بعدم جواز التمسّك بالعموم فيما نحن فيه -
ص: 373
بحسب مقام الإثبات، لأنّه قد دلّت الروايات الواردة عن أهل البيت(علیهم السلام) على صحّتهما وجوازهما، مع عدم صحّتهما لولا تعلّق النذر بهما، خلافاً للعامّة حيث إنّهم قائلون بالجواز مطلقاً.
وأمّا بحسب مقام الثبوت فيظهر من الكفاية التفصّي عن الإشكال بوجوه:((1))
أحدها: القول بوجود الرجحان الذاتي فيهما المستكشف بدليل خاصّ، وإنّما لم یؤمر بهما لوجود مانع يرتفع بسبب تعلّق النذر بهما.
ثانيها: أن يكون النذر ملازماً لعروض عنوان راجح عليهما بعدما لم يكونا كذلك.
ثالثها: تخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذا الدليل، وعليه نقول بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر.
لا يقال: نعم، لا مانع من التخصيص، إلّا أنّه لا يتمكّن من إتيانهما بقصد التقرّب؛ لأنّ وجوب الوفاء بالنذر إنّما يكون توصّلياً ولا يعتبر فيه قصد القربة.
لأنّه يقال: لا مانع من صحّة الإتيان بقصد التقرّب بعد تعلّق النذر بإتيانهما عبادياً ومتقرّباً بهما منه تعالى.
هذا، والّذي ينبغي أن يقال في المقام: - بعد الغضّ عن عدم ارتباط ما ورد في صحّة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات إذا تعلّق النذر بهما بما نحن فيه، لأنّ القائل بجواز التمسّك بعموم النذر لإثبات صحّة الوضوء بالمائع المضاف إنّما تمسّك به لإثبات صحّة الوضوء في مورد لا يكون متعلّقا للنذر أو يكون مطلقاً تعلّق به النذر أم لا، وهذا بخلاف الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات فإنّ صحّتهما إنّما تكون فيما إذا تعلّق النذر بهما - أنّ ما أفاد(قدس سره) في تصحيح النذر المتعلّق بالصوم والإحرام بحسب مقام الثبوت غير وجيه.
ص: 374
أمّا الوجه الأوّل: (وهو القول بوجود الرجحان الذاتي) فهو منافٍ للروايات الواردة فيهما مثل أنّ الإحرام قبل الميقات يكون كالصلاة قبل الوقت((1)) وغيره ممّا یدلّ على عدم وجود رجحان ذاتي فيهما أصلاً.
وأمّا الوجه الثاني، ففيه: أنّ كون النذر ملازماً لعروض عنوان راجح عليهما ممّا يعلم خلافه، فما معنى هذا العنوان الراجح الّذي ليس له أثر في الأخبار ولا يجيء في الأذهان؟
وأمّا الوجه الثالث، ففيه: أنّه بناءً على ما ذهب إليه في مبحث التعبّدي والتوصّلي من عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر،((2)) يرد عليه أنّ قدرة المكلّف على إتيان الصوم بقصد التقرّب موقوف على كونه متعلّقاً لأمر «أوفوا بالنذور» وكونه متعلّقاً لهذا الأمر موقوف على قدرة المكلّف على إتيان الصوم بقصد التقرّب (وقد اُشير إلى هذا الإشكال الوارد عليه بتقريب آخر في مبحث المقدّمة عند البحث في تصحيح الواجبات الغيرية وعدم استقلالها). وأمّا بناءً على ما ذهبنا إليه من إمكان أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر وعدم وقوع محال منه،((3)) فلا إشكال.
فالأظهر أن يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال: إنّ الدليل الدالّ على تقييد موضوع حكم وجوب الوفاء بالنذر بكونه طاعة لله تعالى مخصّص بدليل وجوب الوفاء بالنذر المتعلّق بالصوم في السفر والإحرام قبل الميقات. ولا يرد علينا ما أوردناه على المحقّق المذكور، كما لا يخفى.
ص: 375
التنبيه الخامس: دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص
إذا قال المولى: «أكرم کلّ عالم» وعلم عدم وجوب إكرام زيد مثلاً وشكّ في أنّه عالم حتى يكون العامّ مخصّصاً بدليل عدم وجوب إكرامه، أو جاهل حتى لا يكون دليل عدم وجوب إكرامه مخصّصاً لعموم العامّ؟ وهذا بخلاف الشكّ الواقع في التخصيص في سائر الموارد، مثل ما إذا قال: «أكرم العلماء» وعلم بأنّ زيداً عالم وشكّ في شمول العامّ عليه من جهة كونه من أفراد المخصِّص. وأمّا في ما نحن فيه، عدم محكومية هذا الفرد بحكم العامّ ومحكوميته بحكم آخر معلوم، وإنّما الشكّ وقع في كونه فرداً للعامّ حتى يكون خروجه عن حكمه ومحكوميته بحكم آخر تخصيصاً، أو لا يكون فرداً له حتى يكون خروجه تخصّصاً؟
وهذا معنى الكلام المعروف بينهم: إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصّص فأيّهما أولى؟
مثال ذلك: نعلم بعدم جواز سبّ المؤمن ودلّ الدليل على حرمة سبّه، ودلّ دليل آخر على جواز لعن بني اُميّة قاطبة، فهل يكون خروج المشكوك إيمانه منهم من تحت عموم حرمة سبّ المؤمن من جهة عدم إيمانه حتى يكون خروجه خروجاً موضوعياً وعلى نحو التخصّص، أو مع أنّه مؤمن وفرد للعامّ خرج عن عمومه بالتخصيص؟
ذهب بعضهم إلى جواز التمسّك بأصالة العموم والقول بعدم كونه فرداً للعامّ لأنّ الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في ورود التخصيص على العامّ، ومقتضى الأصل عدمه، فيحكم بعدم كونه مصداقاً للعامّ. ونتيجته إجراء کلّ حكم كان ثابتاً لهذا الفرد بکلّ عنوان كان غير عنوان العامّ.
وذهب بعضهم إلى عدم جواز التمسّك بأصالة العموم في إحراز كونه معنوناً بغير عنوان العامّ، لاحتمال اختصاص حجّیتها بما إذا شكّ في كون فرد العامّ محكوماً
ص: 376
بحكمه، لا في كون المعلوم خروجه عن حكم العامّ من أفراده. ولأنّ المثبتات من الاُصول اللفظية إنّما تكون حجّة إذا كان بناء العقلاء وسيرتهم عليها. ولم يعلم بناؤهم على ذلك.((1))
هذا، ولكنّ التحقيق في المقام موقوف على ذكر مقدّمة قد مرّت الإشارة إليها، وهي: أنّ باب الحقيقة والمجاز ليس افتراقهما من جهة أنّ استعمال اللفظ إذا كان في المعنى الحقيقي يكون حقيقةً، وإذا كان في غير ما وضع له يكون مجازاً. بل إنّما يكون من جهة أنّ المتکلّم تارة: يلقي اللفظ ويستعمله في المعنى الموضوع له ليحضر ذلك المعنى في ذهن المخاطب ويحكم عليه بما يريد، وهذا الاستعمال يكون استعمالاً حقيقياً؛ ومرادهم من أصالة الحقيقة كون استعمال اللفظ على هذا النحو. وتارة: يستعمل اللفظ في الموضوع له ولكن لا من جهة أن يحضر المعنى الموضوع له في ذهن المخاطب ويحكم عليه، بل من جهة أنّه أراد أن يكون هذا المعنى عبرة وطريقاً لالتفات المخاطب إلى معنى آخر غير المعنى الموضوع له، فيستعمل اللفظ في ما وضع له اللفظ لكن يريد منه معنىً مناسباً له ادّعاءً، وهذا الاستعمال يكون استعمالاً مجازياً. ولولا ذلك واستعمال اللفظ في المعنى الموضوع له وجعله عبرة ومرآة لمعنى آخر لما كان هذا الاستعمال مليحاً ولمّا يساعده الذوق السليم. هذا إذا كان معنى اللفظ جزئياً لا يشتمل على الكثير.
وأمّا إذا كان الّفظ معنىً واحداً مشتملاً على الكثير مثل: «كل عالم» و«العلماء»، فتارة: يستعمل ذلك اللفظ - الموضوع لهذا المعنى الوحدانيّ المشتمل على الكثير - ليحضر جميع الأفراد المنطوية في هذا المعنى في ذهن المخاطب ويحكم على جميع هذه الأفراد.
ص: 377
وتارة اُخرى: يستعمله في معناه لكن يجعله عبرة لمعنى آخر كما مرّ. وثالثة: يريد المتکلّم إحضار بعض هذه الأفراد المنطوية في هذا المعنى الواحد بالإجمال، من جهة أنّ حكمه لا يشمل جميع هذه الأفراد بل إنّما يريد أن يشمل ذلك البعض دون غيره، لكن حيث لا يكون لهذه الأفراد - الّتي يريد إحضارها في ذهن المخاطب - لفظ خاصّ، ولا يمكنه التعبير عن کلّ واحد منها بلفظ خاصّ لأنّه يوجب التطويل، فيستعمل ذلك اللفظ فيما وضع له - وهو المعنى المذكور - حتى يحضر جميع الأفراد المنطوية في ذهن المخاطب ويحكم عليه، ويخرج ما يريد إخراجه وعدم شمول حكمه له بأدوات الإخراج.
فإذا شكّ في هذا اللفظ المستعمل الموضوع للمعنى الواحد المشتمل على الكثير، هل المتکلّم استعمله في المعنى الموضوع له ليحضره في ذهن المخاطب ويحكم عليه، أو لكونه عبرة وسبباً لانتقاله إلى معنى آخر؟ يكون المرجع أصالة الحقيقة.
وإن وقع الشكّ في أنّه أراد إحضار جميع الأفراد المنطوية في هذا المعنى الواحد في ذهن المخاطب ليحكم على جميعها، أو ليحكم على بعضها ويخرج بعضها الآخر بأداة الإخراج؟ وبعبارة اُخرى: بعد العلم بكون جميع الأفراد مراداً للمتكلّم بحسب الإرادة الاستعمالية لو شكّ في كون جميع الأفراد مراداً له بحسب الإرادة الجدّية بمعنى أنّه استعمل اللفظ في هذا المعنى الواحد بالإجمال ليحضر جميع الأفراد المنطوية في هذا المعنى الواحد ويحكم على جميعها، أو على بعض تلك الأفراد؟ يكون المرجع أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدّية. ويعبّر عن جميع ذلك بأصالة العموم، فهي تكون مركّبة من أصالة الحقيقة وأصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدّية.
إذا عرفت هذه المقدّمة، فاعلم: أنّ القائل بجواز التمسّك بأصالة العموم في المقام لو أراد التمسّك بها لإثبات أنّ زيداً عالم، ففساده غير محتاج إلى بيان؛ لأنّ التمسّك بها لا يثبت كونه عالماً.
ص: 378
وإن أراد إثبات دخوله في المراد الاستعمالي دون مراده الجدّي، فهذا أيضاً معلوم الفساد؛ لأنّه لا يعلم كونه مراداً للمتكلّم بحسب إرادته الاستعمالية.
وأمّا لو أراد بالتمسّك بأصالة العموم إثبات أنّه غير عالم فلا يثبت بها؛ لأنّ قول القائل: «أكرم کلّ عالم» لا یدلّ على أزيد من وجوب إكرام كل فرد من العلماء، وأمّا أنّ من لا يجب إكرامه يكون جاهلاً وليس من العلماء فلا يثبت به، ولا يستدلّ العقلاء لإثبات كونه غير عالم بأصالة العموم، كما لا يستدلّون بها لنفي كونه عالماً.
ثم لا يخفى: أنّه لا مجال لتوهّم كون النزاع في المقام من صغريات النزاع في التمسّك بعموم العامّ في الشبهة المصداقية أو نظيرها، كما توهّم بعض أعاظم المعاصرين.
التنبيه السادس: دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص للتردّد بين فردين
إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال في دليل منفصل: «لا يجب إكرام زيد»، ودار الأمر بين أن يكون المراد منه هو زيد العالم حتى يكون تخصيصاً لعموم «أكرم العلماء»، أو زيد الجاهل حتى يكون خروجه عنه بالتخصّص.
والظاهر جواز التمسّك بأصالة العموم لإثبات وجوب إكرام زيد العالم؛ لأنّ عموم «أكرم العلماء» يشمله وليس في البين دليل تامّ یدلّ على تخصيص هذا العموم بغير زيد العالم، وهذا واضح.
وإنّما الإشكال فيما إذا استعقب عمومه بحكم إلزاميّ كقوله: «لا تكرم زيداً» أو «اضربه»، ودار الأمر بين أن يكون زيداً العالم أو زيداً الجاهل.
فربّما يقال: بعدم جواز التمسّك بأصالة العموم في مثل ذلك الّذي نعلم بتوجه تكليف نحو المكلّف خلاف التكليف الّذي يكون العامّ متكفّلاً له من جهة وجود الحجّة الإجمالية، وهو قوله: «لا تكرم زيداً» أو «أهنه» فيدور الأمر بين حرمة إكرام زيد العالم أو زيد الجاهل، ومقتضى ذلك هو الاحتياط.
ص: 379
لا يقال: هذا إذا لم يكن عموم العامّ موجباً لتعيّن الحرمة في طرف زيد الجاهل.
لأنّه يقال: إنّ دليل العموم بمنزلة الكبرى الكلّية وغير متكفّلة لحال الأفراد، وليس حاله حال البيّنة القائمة على أنّ زيداً العالم واجب الإكرام الموجبة لتعيّن الحرمة في الطرف الآخر، فإنّها متكفّلة لبيان حال الفرد، دون دليل العامّ الّذي ليس له نظر إلى خصوص حال الفرد، فلا يكون موجباً لتعيّن الحرمة في الطرف الآخر، فيسقط العموم عن الحجّية بالإضافة إلى زيد العالم قهراً. وهذا البيان موافق لما في تقريرات بحث بعض الأعاظم من المعاصرين((1)) مع أدنى تفاوت في العبارة. وإنّما لم نعبّر ما في كلامه بأنّ عموم العامّ لا يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالي بل هو باقٍ على حاله.
ثم إنّه أفاد جواباً عن هذا الإشكال: بأنّ دليل العامّ وإن لم يكن متكفّلاً لحكم خصوص فرد ابتداءً إلّا أنّه يثبت له الحكم بعد انضمام الصغرى الوجدانية - وهي «أنّ زيداً عالم» - إلى الكبرى الكلّية المستفادة من دليل العامّ لا محالة. فإذا ثبت له الحكم الوجوبي بمقتضى العموم ترتفع عنه الحرمة بالملازمة، فتتعيّن الحرمة في الطرف الآخر بالملازمة والمثبت من الاُصول اللفظية لكونها ناظرة إلى الواقع يكون متّبعاً.((2))
ثم لا يخفى عليك: أنّ المعاصر المذكور لم يتعّرض للمبحث المذكور في التنبيه السابق، ولعلّ كان نظره إلى حجّية المثبتات من الاُصول اللفظية فلا فائدة حينئذٍ للتعرّض له، لأنّه يعد هذا الملاك يجوز التمسّك بعموم العامّ لإثبات عدم كون ما شكّ في فرديّته فرداً له بعد العلم بكونه محكوماً بحكم غير العامّ.
وفيه: ما لا يخفى من الفرق بين المبحثين؛ لأنّ في المبحث السابق إنّما قلنا بعدم جواز التمسّك بعموم العامّ لإثبات عدم كون ما شكّ في كونه مصداقاً للعامّ مصداقاً له من
ص: 380
جهة عدم استقرار بناء العقلاء على التمسّك بأصالة العموم في هذه الموارد لا من جهة عدم حجّية مثبتات الاُصول اللفظية، كما لا يخفى.
تذنيب: لا يخفى عليك: أنّ بعض الأعاظم من المعاصرين الّذي أشرنا إلى كلامه في هذا التنبيه، حيث رأى أنّ القائل بجواز التمسّك بعموم العامّ في الشبهات المصداقية ربما يتمسّك لإثبات مراده بما عن المشهور بل عن جميع الفقهاء - رضوان الله عليهم((1)) - من إثبات الضمان فيما إذا دار الأمر بين كون اليد ضمانية أو أمانية، وكون من بيده المال مدّعياً وصاحب المال منكراً؛ لأنّه لولا جواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية تكون هذه الفتوى منهم على خلاف القواعد، إذ القواعد تقتضي أن يكون صاحب المال مدّعياً لأنّه يدّعي ثبوت شيء في ذمّة ذي اليد، وأن يكون من بيده المال منكراً، ولكنّهم تمسّكاً بعموم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»((2)) أفتوا بذلك مع وقوع الشكّ في كون هذه اليد يد أمانية الّتي اُخرجت بالتخصيص عن عموم على اليد، أم لا.فصار في مقام تصحيح فتوى المشهور ولو لم نقل بجواز التمسّك بعموم العامّ في الشبهة المصداقية.((3))
ولكنّ الّذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّ فتوى المشهور بل جميع الفقهاء - لأنّي لم أقف على أحد أفتى على خلاف ذلك - في هذه المسألة، إنّما تكون مستنداً إلى الروايات الواردة في المقام، من جملتها ما رواه في الوسائل في كتاب الوديعة عن الكليني(قدس سره) بإسناده عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر:
ص: 381
إنّما كانت لي عليك قرضاً، فقال:«المال لازم له إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة».((1)) وغيرها من الروايات.((2))
اللّهمّ اجعل خاتمة أمرنا خيراً، وصلّ على نبيّك وآله الطاهرين.
ص: 382
هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص؟((1)) بأن يكون العامّ حجّة للمكلّف في مقام الاحتجاج على المولى، كما إذا دلّ دليل العامّ على عدم تكليف في مورد فأخذه المكلّف وبنى عليه من غير فحص عن مخصّصه مع وجوده واقعاً، أم لا يكون حجّة كذلك إلّا بعد الفحص عن المخصِّص؟
وليعلم أوّلاً: أنّ أوّل من تکلّم بهذه المسألة - بعد عدم كونها مورداً للبحث عند السابقين عليه من العلماء - هو أبو العباس بن سُرَيج الشافعي((2)) واختار عدم حجّية العامّ قبل الفحص عن المخصِّص.((3))
وخالفه في ذلك تلميذه أبو بكر الصَيْرَفي وذهب إلى حجّیته قبل الفحص.((4))
ص: 383
ووافقه في ذلك البيضاوي، والعلاّمة في أحد قوليه، والمدقّق الشيرواني، وغيرهم.
وذهب السبكي من العامّة إلى التفصيل، وقال بعدم حجّیته قبل الفحص في حياة الرسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وحجّيته بعده(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ).((1))
وذهب الشيخ(قدس سره)،((2)) والسيّد(قدس سره)((3)) - على ما يظهر منهما في مسألة جواز إسماع العامّ المخصَّص مع عدم ذكر مخصّصه -، وصاحب المعالم،((4)) والزبدة،((5)) وجلّ المتأخّرين إلى المنع،((6)) وإليه ذهب من العامة أبو العباس المذكور، وتبعه الغَزالي،((7)) والآمدي،((8)) والحاجبي مدّعياً للإجماع،((9)) والأنباري مدّعياً لإجماع الاُصوليين، ومن الإمامية العلّامة مدّعياً للإجماع في موضع من التهذيب،((10)) وكذا السيّد عميد الدين - رحمة الله عليهما - في شرح التهذيب.((11))
وكيف كان فلابدّ لنا قبل الورود في المطلب من بيان أنّ هذا النزاع هل يكون
ص: 384
منحصرا في حجّية أصالة العموم، أو يعمّها وسائر الاُصول اللفظية كأصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق، أو يكون أعمّ من الاُصول اللفظية ويشمل کلّ دليل شرعي، فيقع النزاع في کلّ دليل ولو كان خاصّاً في أنّه حجّة قبل الفحص عمّا يعارضه مع احتمال وجود معارض أقوى منه له أو لا؟ وجوه: أظهرها الأخير؛ لأنّه لو قلنا بعدم حجّية أصالة العموم قبل الفحص فلا فرق بينها وبين سائر الاُصول اللفظية والأدلّة الشرعية، كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ الشيخ(قدس سره) قد أفاد في وجه عدم جواز التمسّك بعموم العامّ قبل الفحص عن المخصِّص، كما في تقريرات بحثه، بقوله: «إنّ العلم الإجمالي بورود معارضات كثيرة بين الأمارات الشرعية الّتي بأيدينا اليوم حاصل لمن لاحظ الكتب الفقهية واستشعر اختلاف الأخبار، والمنكر إنّما ينكره باللسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان بذلك، ولا يمكن إجراء الاُصول في أطراف العلم الإجمالي - كما قرّرناه في محلّه - فتسقط العمومات عن الحجّية للعلم بتخصيصها إجمالاً عند عدم الفحص. وأمّا بعد الفحص فيستكشف الواقع ويعلم أطراف الشبهة تفصيلاً بواسطة الفحص...»، إلى أن قال:
«فإن قلت: إنّ هذا العلم الإجمالي إنّما هو من شعب العلم الإجمالي بمطلق التكاليف الشرعية الّتي تمنع عن الرجوع إلى الاُصول في مواردها، واحتمال ثبوت التكليف في موارد العامّ وأفراده إنّما هو بواسطة ذلك العلم الإجمالي باقٍ وحكم ذلك العلم الإجمالي باقٍ بعد الفحص ما لم يقطع بعدم المخصِّص، وقيام الظنّ مقامه يوجب التعويل على الظنّ المطلق كما عرفت فيما تقدّم.
قلت: إنّ العلم الإجمالي بثبوت مطلق التكاليف الّذي أوجب الفحص عن مطلق الدليل يكفي في رفع حكمه الأخذ بظاهر العموم المعمول فيه الاُصول، وما هو
ص: 385
المدّعى في المقام يغاير ذلك العلم الإجمالي ولا مدخل لأحدهما بالآخر وجوداً وعدماً، كما لا يخفى على المتأمّل».((1)) انتهى كلامه رفع الله مقامه.
أمّا المحقّق الخراساني(قدس سره) بعد ما أفاد من أنّ حجّية أصالة العموم واعتبارها في الجملة إنّما يكون من باب الظنّ الخاصّ لا الظنّ المطلق؛ لأنّه لو قلنا بحجّيته من باب الظنّ المطلق فليست هي حجّة حقيقة بل الحجة إنّما يكون ظنّ المكلّف بالتكليف. ومن أنّ حجّیتها إنّما تكون من باب الظنّ النوعي لا الشخصي.
أفاد بأنّه مع العلم بتخصيص العموم تفصيلاً أو إجمالاً لا مجال للنزاع في حجّیته وعدمها؛ لأنّ النزاع في جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص إنّما يجري بعد الفراغ عن عدم حجّية العموم فيما إذا علم تخصيصه إجمالاً أو تفصيلاً.
وقال: إنّ التحقيق عدم جواز التمسّك به قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص، كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنّة، وذلك لأجل أنّه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقلّ من الشكّ، كيف وقد ادّعى الإجماع على عدم جوازه فضلاً عن نفي الخلاف عنه وهو كافٍ في عدم الجواز، كما لا يخفى، إلخ.((2))
ويمكن الإشكال عليه: بأنّه إن أراد من كون العامّ في معرض التخصيص وقوع احتمال التخصيص بالنسبة إليه، فلا إشكال في استقرار سيرة العقلاء على العمل بالعامّ في مورد احتمال التخصيص.
وإن أراد كون العامّ في مظنّة ذلك، فهذا ممّا لم يقل به أحد.
وإن أراد كونه بحيث يكون قابلاً لورود التخصيص عليه، فما من عام إلّا وهو يكون كذلك.
ص: 386
ومع ذلك، يمكن أن يوجّه ما أفاده بأنّه وإن كان بناء العقلاء استقرّ على جواز العمل بالعامّ قبل الفحص - بالمعنى الّذي ذكرنا في صدر المبحث - في المحاورات العرفية وبالنسبة إلى الموالي والعبيد، ولكن إذا لم يكن المولى من الموالي العرفية ووضع لعبده تكاليف ووظائف، ويريد منه العمل على وفق هذه الوظائف كما هو شأن الشارع المقدّس، ولم يرضی بترك عبده العمل على طبق هذه التكاليف، فلابدّ لهذا العبد الفحص عن هذه الوظائف، فلا يجوز له إذا اطّلع على عامّ في كلام المولى العمل به من غير فحص عن المخصِّص مع احتمال أن يكون هذا العامّ مخصّصاً في كلامه الآخر.
وبالجملة: إذا علم العبد بأنّ للمولى تكاليف كثيرة متوجّهة إليه لا عذر له لو ترك الفحص عن هذه التكاليف والتفحّص عن الدليل والحجّة. هذا، مضافاً إلى أنّ العبد لو علم بأنّ المولى أمره بالفحص عن أحكامه كما هو المراد من قوله:
«طلب العلم فريضة على کلّ مسلم»،((1)) وظاهر آية النفر،((2)) وسائر الآيات والروايات الواردة في مقام الترغيب والتحريض على الفحص،((3)) فكما أنّ هذه الروايات تمنع عن العمل بالاصول العملية تمنع أيضاً عن العمل بالاُصول اللفظية.
ويمكن أن يقال: إنّ المراد من العلم في الروايات الّتي أمر الشارع فيها بطلب العلم ليس هو العلم الوجداني والملكة النفسانية، وإنّما المراد هو الدليل والحجّة، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾،((4)) وغيرها من الآيات كالآية الّتي تدعو الكفّار بإخراج علمهم، فإنّه إن كان المراد من العلم هو الملكة النفسانية لا يمكن إخراجها.
ص: 387
ولا فرق فيما ذكر من وجوب الفحص عن المخصصات الواردة على العمومات وعن المعارض لما يحتمل أن يكون له معارض أقوى، كما قدّمناه في صدر البحث.
ولا يخفى عليك: أنّ وجوب الفحص ليس وجوباً نفسياً بل يكون وجوبه غيرياً وتطفّلياً، بمعنى أنّه لا يعاقب تارك الفحص إلّا بعقاب تارك الواقع إذا كان في موردٍ ترك الفحص فيه حكم وخالفه.
وأيضاً لا يخفى عليك: أنّه لا يرد على هذا البيان ما اُورد على وجوب الفحص من جهة العلم الإجمالى من الإشكال.((1)) تارة: بأنّ ما يوجب عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص (وهو العلم الإجمالي) لا يرفع بالفحص فبسبب الفحص لا يصحّ القول بجواز العمل بالعامّ وحجّيته ولا يوجب الفحص تغييراً في حاله.
واُخرى: بأنّه إذا كان الملاك في وجوب الفحص العلم الإجمالي بوجود المخصِّصات فلو تفحّص الفقيه حتى ظفر بالمقدار المتيقّن ينحلّ علمه الإجمالي - لا محالة - وفيما زاد على هذا المقدار يصير شكّه بدويّاً، فلا يجب الفحص عن جميع العمومات. مع أنّا نرى أنّ الفقهاء يتفحّصون عن المخصِّص في جميع الموارد، كما لا يخفى.
ولا فرق فيما ذكر بين الاُصول اللفظية والعملية.
فما أفاد في الكفاية،((2)) وما يظهر من بعض الأعاظم من المعاصرين:((3)) من الفرق بأنّ الفحص في المقام عمّا يزاحم الحجّة بخلافه في الاُصول العملية؛ فإنّه بدون الفحص لا حجّة، ضرورة أنّ العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة.
ص: 388
ليس في محلّه؛ لأنّه إن اُريد بذلك أنّ المكلّف لو ترك الفحص في الاُصول اللفظية عمّا يعارضها ولم يكن في الواقع حكم يكون العامّ حجّة كما إذا تفحص المكلّف ولم يجد شيئاً، فبابه وباب الفحص في الاُصول العملية واحد بلا فرق بينهما؛ لأنّ فى كليهما يكون العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان. وإن اُريد أنّ ترك الفحص في مجاري الاُصول العملية مع عدم حكم للشارع واقعاً أو عدم بيان يجده المكلّف عند الفحص يكون تجرّياً على المولى، فلا فرق فيه بين مجاري الاُصول العملية واللفظية؛ لأنّ في مجاري الاُصول اللفظية أيضاً لو ترك الفحص يكون متجرّياً.
ثم إنّه لا ريب في أنّ مقدار الفحص يختلف بحسب اختلاف المباني،((1)) فمن يرى وجوب الفحص من جهة العلم الإجمالي((2)) فمقدار الفحص - بحسب مبناه - إنّما يكون بمقدار يظفر به على المقدار المتيقّن من المخصِّصات.
ومن يرى وجوبه من جهة الظنّ بوجود تلك المخصِّصات((3)) فيجب عليه الفحص بمقدار يرتفع به ظنّه.
وأمّا من كان موافقاً للمحقّق الخراساني(قدس سره)، فحيث لم يعلم مراده من كون العامّ في معرض التخصيص ولم يفهم منه معنىً معقولاً صحيحاً، فلا يمكن تعيين مقداره بحسب مبناه. اللّهم إلّا أن يقال بكون مراده ما ذكرناه وإن كان كلامه ليس وافياً له، فيكون مقدار الفحص في کلّ عامّ يحتمل تخصيصه في كلام الشارع بمقدار لا يصل إلى
ص: 389
حدّ العسر والحرج، لا أن يهمل أمر الفحص بالمرّة، أو إذا رأى عامّاً أو دليلاً آخر حكم بمجرّده وعمل به وأفتى على طبقه من غير فحص عن مخصّصه أو معارضه.
فمسألة الفحص في باب الاجتهاد من التكاليف المهمّة لمن كان في مقام الاجتهاد والفتوى، فهو محتاج بعد تحصيل العلم - بالصرف والنحو بمقدار يعرف به ما يراد من الألفاظ المفردة والمركّبة وأنحاء هيئاتها، وباللغة، والفقه، ومعاقد الإجماعات، وفتاوى العلماء، وغيرها - إلى كثير اطّلاع من القرآن المجيد وتفاسير الآيات الكريمة زائداً على آيات الأحكام؛ لأنّ للاطّلاع على الكتاب والتفاسير وأقوال علماء التفسير دخلاً عظيماً في استنباط الأحكام، وإلى علم الدراية والرجال لا بمعنى الاكتفاء بتصحيح الغير بل بصرف جهده في معرفة الرجال بل لا يبعد أن يقال بلزوم احتياج المجتهد إلى الاطّلاع على فتاوي العامّة وما هو المشهور بينهم بحسب الأزمنة المختلفة والاطّلاع على كتب أخبارهم.
وبالجملة: فأمر الاجتهاد صعب جدّاً؛ ولنعم ما قال الشيخ(قدس سره) في الفرائد. «أعاننا على الاجتهاد الّذي هو أشقّ من طول الجهاد».((1)) والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
ص: 390
هل الخطابات الشفاهية مثل: «يا أيّها الناسُ» و «يا أيّها الذين آمنوا» مخصوص بالمشافهين ومن كان حاضراً في مجلس التخاطب، أو يعمّ غيره ممّن كان غائباً عن مجلس الخطاب بل معدوماً؟ فيه خلاف.
والظاهر أنّ مرادهم بهذه الخطابات الخطابات القرآنية. وهذا الاختلاف حدث بين القدماء من الاُصوليّين وبقي إلى الآن ذكره في كتب الاُصول.
وقد أفاد المحقّق الخراساني(قدس سره) في تحرير محلّ النزاع وجوهاً ثلاثة.((1))
والظاهر عدم كونها وجوهاً لتحرير محلّ النزاع وما يرجع إليه روح البحث في المقام، بل إنّما هي وجوه لما يمكن أن يكون ملاك هذا النزاع.
أحدها: أن يكون ملاك النزاع إمكان تعلّق التكليف بالمعدومين كما يصحّ تعلّقه بالموجودين وعدمه.
ثانيها: صحّة المخاطبة مع الغائبين عن مجلس الخطاب - سواء كانوا موجودين أم معدومين - وعدمها.
ثالثها: أنّ بعد معلومية إفادة مدخول أدوات الخطاب العموم والشمول
ص: 391
للحاضرين في مجلس الخطاب والغائبين مطلقاً قبل دخول الأدوات، فهل يكون بعد دخول أداة الخطاب عليه مع كونها موضوعة للخطاب إلى الحاضرين باقٍ على حاله من إفادة العموم أم لا؟ وهل تكون الأدوات قرينة على عدم استعمال المدخول في المعنى الحقيقي؟ وبالجملة: يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور المدخول في العموم، ورفع اليد عن ظهور أدوات الخطاب في اختصاصها بالمشافهة؛ فيكون ملاك النزاع على هذا الوجه (الثالث) لغوياً.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ ملاك النزاع ليس هو الوجه الأوّل ظاهراً؛ لأنّهم قد صرّحوا بأنّه لو قلنا باختصاص الخطاب بالمشافه يجب إثبات الحكم على غيره من المكلّفين بقاعدة الاشتراك، وهذا ينادي بأنّهم يجوّزون توجيه التكليف نحو الغائبين عن مجلس الخطاب.((1))
كما أنّ الظاهر أنّه ليس الملاك الوجه الثالث.
وعلى کلّ حال، فنحن نتكلم في الوجوه الثلاثة المذكورة ونقول:
أمّا الوجه الأوّل: وهو أن يكون ملاك النزاع إمكان توجيه الخطاب المتكفّل للتكليف بما أنّه تكليف لغير من كان حاضراً في مجلس الخطاب، فلا ريب في أنّه إن اُريد بإمكانه إمكان تكليف المعدوم وبعثه وزجره فعلاً، فلا يكون له معنىً معقولاً، ولا يظنّ بأحد أن يكون مراده هذا. وإن اُريد منه مجرد إنشاء الطلب وإلقاء اللفظ حتى ينتزع منه التكليف والطلب وبعث المعدوم في ظرف وجوده، فهذا معنى معقول لا مانع منه عقلاً، فلو أراد المولى صدور الفعل عن عباده المترتّبين في سلسلة الوجود فلا مانع من أن ينشأ الطلب حتى ينتزع منه التكليف على کلّ من يوجد في ظرف وجوده.
ص: 392
هذا، ولكن المحقّق الخراساني(قدس سره) أفاد في هذا الوجه: بأنّ المراد - من تعلّق الطلب بما هو أعمّ من الحاضرين وغيرهم من المعدومين - إن كان تعلّق الطلب فعلاً وحقيقةً، فهو ممتنع.
وإن كان المراد منه إنشاء الطلب وتعلّقه به مقيّداً بوجود المكلّف، فهو بمكان من الإمكان.
وإن كان المراد تعلّق الطلب بما هو أعمّ على نحو الإطلاق - بمعنى مجرّد إنشاء الطلب بلا بعث وزجر - وفائدة هذا الإنشاء صيرورته فعلياً بعد وجود الشرائط وفقد الموانع، فلا مانع منه أيضاً.((1))
وأنت خبير بأنّ الوجه الأخير راجع إلى الوجه الثاني، لأنّ الطلب الإنشائي أيضاً لا يتعلّق بالمعدومين فعلاً. ولو قلنا بأنّ الطلب موضوع للطلب الإنشائي الإيقاعي، كما هو مختار المحقّق المذكور، فلا فائدة في الطلب الإنشائي من غير أن يكون متعلّقاً بالمكلّف في ظرف وجوده. وانتزاع الطلب وصيرورته قابلاً لتحريك العبد بعد وجوده إنّما يكون من جهة تعلّق الطلب بالمكلّف في ظرف وجوده وإنشائه لانبعاثه كذلك، لا من جهة مجرّد إنشاء الطلب.
فالتحقيق أن يقال: إنّ الطلب المتوجه إلى المعدوم في حال كونه معدوماً محال، وإلى المعدوم بحسب حال وجوده لا مانع منه؛ وهذا أمر لم ينكره أحد من العلماء.
لا يقال: إنّ الطالبية والمطلوبية لابدّ وأن تكونا متكافئتين في القوّة والفعل كما هو شأن المتضائفين، وعليه فلابدّ من وجود طرفي التكليف حتى يتحقّق.((2))
فإنّه يقال: فرق بين الإضافة المقولية وبين الأعراض والصفات ذوات الإضافة كالعلم والقدرة وما شابههما؛ فإنّ فيها لا يلزم أن يكون كلّ واحد من طرفي الإضافة
ص: 393
موجوداً بالفعل بل يكفي وجود أحدهما؛ ألا ترى أنّ العالم موجود لكن المعلوم ليس بموجود، والقادر موجود والمقدور ليس بموجود، فليكن الطلب والطالب أيضاً من هذا القبيل، فلا مانع من وجود الطلب والطالب مع عدم وجود المطلوب والمطلوب منه فعلاً.
وأمّا الوجه الثاني، وهو: إمكان مخاطبة المعدومين وتوجيه الخطاب نحوهم، فنقول: لا يخفى عليك: أنّ الخطاب عبارة عن توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، والظاهر أنّه لا يجب أن يكون مشتملاً على أدوات الخطاب، بل توجيه الكلام نحو الغير يكون خطاباً سواء كان مشتملاً على أدوات الخطاب أم لا. نعم، لا مضايقة من القول بكون الخطاب فيما كان الكلام مشتملاً على أدوات الخطاب آكد، وهكذا إذا كان مشتملاً على أدوات التنبيه وأسماء الإشارة بل والضمائر. كما أنّ الظاهر أنّ الخطاب لا يجب أن يكون كلاماً بل يحصل بغيره مثل الكتابة.
ولا يجب أن يكون المخاطب موجوداً حين صدور الخطاب من المتكلّم، كما هو حال بعض العبائر المذكورة في الكتب ك «أيّها القرّاء» وغيره.
وأمّا إذا كان الخطاب حاصلاً بالكلام فهو وإن كان يمكن أن يقال بوجوب كون المخاطب موجوداً في مجلس الخطاب، لأنّ الكلام يكون غير قارٍّ بالذات عند القدماء. ولكن في مثل زماننا حيث ظهر خلاف هذا الرأي وثبت بقاء الكلام في عالم العين وقراره، فلا يضرّ بالخطاب الحاصل بالكلام أيضاً عدم وجود المخاطب (بالفتح) عند توجيه الكلام.
وأمّا الكلام في الوجه الثالث: فأفاد المحقّق الخراساني(رحمه الله) بأنّ ما وضع للخطاب، مثل أدوات النداء، لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي فاستعماله في الخطاب الحقيقي يوجب تخصيص ما يقع تلو هذه الأدوات بالحاضرين في مجلس الخطاب، كما أنّ مقتضى إرادة العموم من مدخولها استعمال تلك الأدوات في العموم.
ص: 394
ثم أفاد بعد ذلك بأنّ أدوات الخطاب ليست موضوعة للخطاب الحقيقي بل تكون موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي، فالمتکلّم تارة: يوقع بها الخطاب تحسّراً وتأسّفاً ونحوهما، وتارة: يوقع بها الخطاب حقيقة، فلا يصير استعمال تلك الأدوات في الخطاب الحقيقي سبباً لتخصيصها بمن يصحّ مخاطبته. نعم، دعوى الظهور انصرافاً في الخطاب الحقيقي ليس ببعيد. وهذا إذا لم تكن قرينة على خلافه كما هو الشأن في الخطابات القرآنية مثل: «يا أيّها الذين آمنوا» وغيره، ضرورة عدم اختصاص الحكم فيها بمن كان حاضراً في مجلس الخطاب، كما لا يخفى... إلى آخر ما أفاده(قدس سره).((1))
والّذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّ الخطاب الّذي هو عبارة عن توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ليس من الاُمور الاعتبارية الإنشائية، فإنّ الأمر الاعتباري تارة: لا يكون ممّا بحذائه شيء في الخارج كالملكية والزوجية وإنّما يوجده من بيده الاعتبار، وتارة: لا يكون بحذائه شيء في الخارج ولكن لا يكون وجوده بإنشاء شخص واعتبار معتبر كالفوقية والتحتية، وثالثة: يكون بحذائه شيء في الخارج وينتزع منه هذا الأمر كالمخاطبة الّتي تنتزع من نفس توجيه الكلام نحو الغير، فالخطاب والمخاطبة لا يكون من الاُمور الإنشائية بل إنّما ينتزع من نفس توجيه الكلام نحو الغير.
وأيضاً نقول: لا شكّ في أنّ الألفاظ المفردة إنّما وضعت لمعانيها المخصوصة، كما أنّ وضع الهيئات يكون بإزاء الانتسابات الّتي تكون بين بعض هذه المعاني مع الآخر سواء كان تلك الانتسابات تامة أو ناقصة. فالمتکلّم إذا تکلّم بکلام واستعمل الألفاظ في معانيها الموضوعة لها إمّا يكون إفهام الغير علّة غائية لفعله هذا وهو تکلّمه وتلفّظه بتلك الألفاظ كما إذا أخبر بمجيء زيد أو قيام عمرو إذا كان كلامه
ص: 395
إنشاءً من غير فرق في ذلك بين الخطابات وغيرها. وإمّا تكون غاية فعله وتكلّمه إظهار الاشتياق أو التحسّر أو شيئاً آخر من هذا القبيل، من غير أن تكون علّته وغايته إفهام الغير. ففي كلّ من الموردين يستعمل اللفظ في معناه ولكن غرضه من ذلك يكون إفهام الغير أو غيره، وليس هذا مجازاً لفظياً؛ لأنّه استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وجعله عبرة وطريقاً لمعنى آخر، وإنّما يعدّ هذا من المجازات العقلائية، ولذا لو شكّ المستمع في أنّ الغاية الّتي أرادها المتكلّم من تکلّمه هل هي الإفهام أو غيره؟ يحمل على أنّه أراد الإفهام.
فظهر من ذلك عدم صحّة ما أفاده في الكفاية من كون ما وضع له أدوات الخطاب يكون معنى أعمّ يعبّر عنه بالخطاب الإنشائي الإيقاعي، بل اللفظ يستعمل في معناه الحقيقي وأدوات الخطاب أيضاً تكون موضوعة للخطاب الحقيقي وتستعمل فيه، ولكن المتکلّم تارة يتكلّم بها ويستعملها في معانيها لإفهام الغير، واُخرى لجهة اُخرى، هذا.
إذا عرفت ذلك، فنقول في مقام بيان أصل المطلب: إنّ المراد بإمكان توجيه الخطاب نحو المعدومين وعدمه إن كان إمكانه في حال كونهم معدومين، فلا يمكن قطعاً، وليس قابلاً لأن يكون محلّ النزاع، ولا أظنّ بأحد أن يكون مراده هذا.
وإن كان المراد إمكان مخاطبة المعدومين في ظرف وجودهم لانبعاثهم في هذا الوقت، فلو كان ما يخاطب به شيئاً غير قارٍّ بالذات كالكلام - بحسب رأي القدماء - لا يصحّ به مخاطبة المعدومين، وإن لم يكن كذلك بل كان ما يخاطب به ممّا يبقى منه أثر ويكون قابلاً لتحريك المعدومين في ظرف وجودهم كالخطابات القرآنية بل الخطابات المذكورة في الكتب والرسائل، فلا مانع من مخاطبة المعدومين به في ظرف وجودهم. ومثله ما إذا علم المتکلّم بأنّ كلماته تحفظ وتضبط وتنقل إلى الناس جيلاً بعد جيل. ولا يخفى: أنّ الخطابات القرآنية من هذا القبيل؛ لأنّها اُنزلت لأن تكون سبباً لانبعاث جميع الناس إلى طاعة الله تعالى شأنه.
ص: 396
وحاصل ما ذكرنا: أنّ الخطاب والمخاطبة لا تكون من الاُمور الإنشائية الإيقاعية، كما زعمه صاحب الكفاية، بل إنّما تكون من الاُمور الانتزاعية الّتي تنتزع من نفس إلقاء المتکلّم الكلام نحو الغير للإفهام، فلا تكون أدوات الخطاب موضوعة للخطابات الإيقاعية الإنشائية، بل هي للخطابات الواقعية الحقيقية. فما يظهر من كلامه - من أنّ خطاب المعدومين لا يمكن تصحيحه إلّا إذا قلنا بكون أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي - فاسد جدّاً.
كما أنّ توهّم كون محلّ النزاع جواز مخاطبة المعدومين في حال عدمهم وتوجيه الكلام نحوهم وعدم جوازها، كما يظهر أيضاً من كلامه، بعيد من الصواب؛ لأنّه لا نزاع في ذلك ولا يقول أحد بجواز خطاب المعدومين في حال عدمهم حتى ينحصر طريق تصحيحه على القول بأنّ أدوات الخطاب موضوعة للخطابات الإنشائية.
بل محلّ النزاع إنّما يكون في إمكان توجيه الكلام لإفهام المعدومين - في ظرف وجودهم - ومخاطبتهم، وعدم إمكانه كذلك. وإمكان هذا بعد ما ذكرنا واضح لا سترة فيه إذا كان ما به يتحقّق الخطاب قابلاً لأن يبقى ولو بوجوده الكتبي.
ويدلّ على ما ذكرنا من توجّه الخطابات القرآنية إلى الجميع قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ الله ُ شَهيدٌ بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾.((1))
لا يقال: إنّ ظاهر هذه الآيةیدلّ على خلاف ما استدلّ به، من جهة عطف «وَمَن بَلَغ» على ضمير الخطاب الواقع في كلمة «لاُنذِرَكُم» فلو كان الخطاب شاملاً للمعدومين أيضاً لكان قوله «وَمَن بَلَغ» زائداً.
لأنّه يقال: إنّ المخاطب بهذه الآية هو النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كما یدلّ عليه قوله: «قُلْ»، وفي مثله
ص: 397
لا مجال لدعوى شمول الخطاب للمعدومين كما هو كذلك في سائر المخاطبات الّتي يكون المخاطب فيها رسول الله صلوات الله عليه وآله.
ولا يخفى أنّا لو لم نقل بأنّ المخاطب بالخطابات القرآنية مثل: «يا أيّها الذين آمنوا» و«يا أيّها الناس» يكون جميع المكلّفين وقلنا باختصاصه بالحاضرين في مجلس الخطاب، يلزم منه القول بعدم توجيهها إلى الحاضرين في مجلس النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) والسامعين منه أيضاً؛ لأنّ الخطاب إنّما يكون ملقى على النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وهو المخاطب به، فلا يكون حال الحاضرين في مجلسه إلّا حالنا؛ لأنّ النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يحكي القرآن ويقرأه ولا تكون قراءته كلام الله تعالى إلّا كقراءة غيره. هذا خلاصة الكلام في المقام.
ثم اعلم: أنّهم قد ذكروا لعموم الخطابات الشفاهية ثمرتين.((1))
إحداهما: أنّ الخطابات القرآنية إذا كانت شاملة للموجودين والمعدومين في ظرف وجودهم يصحّ التمسّك بظواهر الألفاظ حتى بناءً على مسلك المحقّق القمي القائل بحجّية ظواهر الألفاط لمن قصد إفهامه؛((2)) إلّا أنّ المحقّق حجّية ظواهر الألفاظ بالنسبة إلى کلّ من سمعها ووصلت إليه.
ثانيتهما: جواز التمسّك بعمومات الكتاب بناءً على التعميم ولو لم يكن المعدومون متّحدين في الصنف والعنوان مع الموجودين، وعدم صحّة التمسّك بعمومات الكتاب بناءً على عدم التعميم ولزوم الاستناد إلى اشتراك المعدومين مع الموجودين في
ص: 398
التكليف، وحيث إنّ دليل الاشتراك لا يكون إلّا الإجماع ولا إجماع عليه إلّا مع اتّحاد الصنف، فلابدّ في إثبات التكليف من اتّحاد الصنف، كما لا يخفى.((1))
وفيه: أنّ الخطابات المتوجّهة إلى المكلّفين قد اُخذ في موضوعاتها عناوين خاصّة، فإذا كان الموجودون في زماننا مثلاً معنونين بتلك العناوين تكون الأحكام المتعلّقة بالمعنونين بالعناوين المذكورة في الخطابات ثابتة لهم أيضاً ولو لم نقل بالتعميم لاشتراكنا معهم في التكليف وحجّية ظواهر الألفاظ لنا أيضاً.
لا يقال: ظواهر الألفاظ حجّة لنا إذا لم يكن المخاطبون بالخطاب واجدين لشرط وخصوصية يحتمل دخلها في التكليف؛ لأنّه على هذا التقدير لا يحتاج المتکلّم إلى البيان، ولا يوجب عدم بيان كونه شرطاً نقضاً لغرضه، فلا يصحّ التمسّك بأصالة الإطلاق لإثبات عدم دخل تلك الخصوصية، كما لا يخفى.((2))
لأنّه يقال: لا يوجد في الخارج أمر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم ممّا لا يوجد عندنا، فعلى هذا لو احتملنا شرطية شيء يوجد في بعضهم دون الآخر وفي بعض حالاتهم دون حالة اُخرى، فلا مانع من دفع هذا الاحتمال بأصالة الإطلاق.
هذا تمام الكلام في الخطابات الشفاهية. والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين. اللّهمّ اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان بحقّ محمد وآله الطاهرين.
ص: 399
ص: 400
لا يخفى عليك: أنّ من المباحث المذكورة في الاُصول البحث في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب ذلك تخصيص العامّ أم لا؟
ومنشأ البحث قوله تعالى: ﴿وَالْ-مُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَ-هُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤمِنَّ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحاً وَلَ-هُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْ-مَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَالله ُ عَزِيزٌ حَكيمٌ﴾((1)) من جهة اختصاص حكم جواز الرجوع بالمطلقة رجعيّاً دون غيرها، فيدور الأمر بين أن يكون المراد من المطلقات العموم، وكان الضمير المذكور في «بعولتهنّ» راجعاً إلى بعض المطلقات؛ أو كان المراد من «المطلقات» الرجعيات خاصّة، حتى يكون الضمير راجعاً إليها؛ أو يقال بعدم جواز التمسّك بالعموم في المقام من جهة إجماله لوجود ما يصلح للقرينية؟
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ المحقّق الخراساني(قدس سره) أفاد في المقام: بأنّ الأمر دائر بين أن يتصرّف في العامّ ويقال بإرادة خصوص ما اُريد من الضمير وارتكاب خلاف الظاهر في جانب العامّ؛ وبين إبقاء العامّ على حاله وارتكاب خلاف الظاهر في ناحية
ص: 401
الضمير بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه؛ أو إرجاعه إلى تمام ما هو المراد من مرجعه توسّعاً في الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة وإلى الكل توسّعاً، نحو «قتلوا بنو فلانٍ فلاناً» فإنّ القتل لا يصدر إلّا من أحدهم، ولكن اُسند إلى الجميع لفرضهم وجوداً واحداً.
وهذا الوجه موجب لارتكاب خلاف الظاهر في ناحية هيئة «بُعُولَتُهُنَّ»؛ لأنّها تدلّ على أنّ بعل کلّ منهنّ أحقّ بردهنّ، وحيث إنّ بناء العقلاء على حجّية أصالة الظهور ليس إلّا فيما إذا كان الشكّ في المراد، وأمّا إذا كان الشكّ في كيفيّة الإرادة والاستعمال مع معلومية المراد فلم يعلم بناءً منهم على حجّیتها، فلا يصحّ التمسّك بها لإثبات استعمال الضمير في تمام أفراد المرجع، حتى يقع التعارض بينها وأصالة الظهور الّتي تكون في طرف العامّ، فيبقى أصالة الظهور في طرف العامّ سليمة عن المعارض.
ثم أفاد بأنّ هذا - يعني التمسّك بأصالة العموم - إنّما يصحّ إذا انعقد للعامّ ظهور في العموم بأن لا يكتنف الكلام بما يوجب إجماله كاكتناف الكلام بالضمير فيما نحن فيه، وإلّا فيحكم عليه بالإجمال، فلابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه الاُصول العملية.((1))
وفيه أوّلاً: أنّ احتمال رجوع الضمير إلى بعض أفراد المطلقات مع إرادة العموم منه ممّا لا ينبغي الالتفات إليه. وكذلك الاحتمال الثالث، أعني رجوع الضمير إلى تمام ما اُريد من لفظ المطلقات على نحو المجاز في الإسناد لا المجاز في الكلمة.
أمّا الاحتمال الثاني، وهو: أن يكون الضمير مستعملاً مجازاً في بعض ما اُريد من المرجع، فنقول: قد ذكرنا في أوّل الكتاب عند البحث عن المبهمات بأنّ كلّها موضوعة للإشارة لا لمفهوم الإشارة((2)) وما وضع له هذا اللفظ بل لما يشير به وتوجد به الإشارة،
ص: 402
سواء في ذلك أسماء الإشارة والموصولات والضمائر، وذلك إنّما يكون من جهة أنّ ذكر ما يشار إليه وما يرجع إليه الضمير يوجب تطويل الكلام فوضعوا هذه الألفاظ للإشارة إليه إذا كان فيما يشار إليه جهة تعيّن تصحّ الإشارة إليه من هذه الجهة، فوضعوا لفظ هذا وهذه وغيرهما للإشارة إلى من كان تعيّنه حضوره، وضمير الخطاب ك«أنت» و«أنتم» لأن يشير به إلى من كان جهة تعيّنه طرفيّته للكلام والخطاب؛ وكذلك «أنا» للمتكلّم لأنّ جهة تعيّنه وأوضح ما به يمكن الإشارة إليه هو كونه متكلّماً؛ ووضعوا ضمير الغائب ك «هو» و«هي» و«هنّ» للإشارة إلى ما تكون جهة تعيّنه كونه مذكوراً في السابق.
فعلى هذا، إذا استعمل الضمير لابدّ وأن يكون مرجعه مذكوراً في الكلام ولا يمكن استعماله وإرادة ما لم يكن مذكوراً في الكلام منه، ففيما نحن فيه لا يصحّ احتمال أن يكون الضمير راجعاً إلى بعض العامّ مع إرادة العموم منه.
وأمّا الاحتمال الثالث، ففيه: أنّ إسناد الشيء المسند إلى البعض حقيقة إلى الكلّ توسّعاً، بأن يفرض المجموع وجوداً واحداً على أن يكون المجاز في الإسناد، صحيح إذا كان الكلّ ملحوظاً شيئاً واحداً كما ذكر وبنحو العامّ المجموعي، وأمّا إذا لم يكن كذلك واُريد الكلّ بنحو العامّ الاستغراقي، كما هو الحال في «بُعُولَتُهُنَّ» لأنّ کلّ واحد من البعولة يكون موضوعاً للحكم فلا معنى لإسناد حكم جواز الرجوع في كلّ واحد من المطلّقات إلى الجميع، وليس هذا من قبيل قولهم: «بنو فلانٍ قتلوا فلاناً» إذا قتله رجل منهم.
وثانياً: ما أفاده من أنّ الكلام إذا كان مكتنفاً بما يوجب إجماله فلا مجال للتمسّك بأصالة العموم ولابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي.
ليس في محلّه؛ لأنّ الكلام يصير مجملاً إذا كان مكتنفاً بقرينة متّصلة تدلّ على إرادة خلاف ظاهر الكلام، لا ما إذا كانت القرينة منفصلة، كما فيما نحن فيه فإنّ قوله تعالى:
ص: 403
﴿وَالْ-مُطَلَّقَاتِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن ﴾((1)) ليس فيه ما يصلح لإجمال ظهور العامّ؛ لأنّ الظاهر أنّ «المطلّقات» استعمل في العموم وضمير ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ يكون راجعاً إليه إلّا أنّه قد علم من الخارج كون المراد من قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾ خصوص الرجعيات.
هذا، والّذي ينبغي أن يقال في المقام: - بعدما ذكرنا سابقاً من أنّ الأصل تطابق الإرادة الجدّية مع الاستعمالية في کلّ مورد شكّ فيه إلّا إذا ثبت خلافه - إنّ مقتضى هذا الأصل إرادة العموم من «المطلّقات»، وكون ضمير «بُعُولَتُهُنَّ» راجعاً إلى «المطلّقات» ويراد منه بالإرادة الاستعمالية جميع المطلّقات. لكن بسبب القرينة الخارجية لا مجال للتمسّك بالأصل المذكور بالنسبة إلى الضمير إلّا في الرجعيات. والله تعالى أعلم.
ص: 404
اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف وعدمه.((1))
وقبل بيان الحقّ في المقام نقول: إنّ المحقّق الخراساني(قدس سره) قد نقل في هذا المقام اتّفاق الكلّ على جواز تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق.
ولا ريب في أنّ اتّفاقهم على ذلك لو ثبت، كما ادّعاه المحقّق المذكور، ليس بمفيد ولا يكون حجّة لجواز التخصيص به، مع أنّه قد اختلفوا في ذلك أيضاً كما يظهر من العضدي،((2)) وبعضهم ذهب إلى التفصيل وقال بجوازه إذا كان المفهوم بالأولوية، وعدم الجواز إذا كان ملاكه مساواة الموضوع المسكوت عنه في الكلام مع الموضوع المذكور فيه.
وأفاد المحقّق المذكور في مقام تحقيق أصل المطلب: بأنّ العامّ وما له المفهوم إذا وردا في كلام أو كلامين وكانا بحيث يكون کلّ منهما قرينة متّصلة للتصرّف في الآخر ودار الأمر بين تخصيص العامّ أو إلغاء المفهوم، لا يمكن التمسّك بأصالة العموم ولا
ص: 405
الأخذ بالمفهوم، فلابدّ من العمل بالاُصول العملية إذا لم يكن أحدهما أظهر من الآخر بحيث يكون مانعاً عن انعقاد الظهور في الآخر.
وأمّا إذا لم يكونا كذلك ولا يكون بينهما هذا الارتباط والاتّصال يعامل معهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر.((1))
ولا يخفى: أنّ هذا ليس تفصيلاً بين ما إذا كان کلّ منهما قرينة متّصلة للتصرّف في الآخر وبين ما إذا لم يكونا كذلك؛ فإنّ الحكم لا يختلف على کلّ حال.
وكيف كان، فالّذي ينبغي أن يقال في المقام - بعد التنبيه على ما ذكرنا سابقاً((2)) بأنّ الملاك في أخذ المفهوم وجود القيد الزائد في الكلام، وأنّ هذا لا يفيد بأزيد من أنّ الموضوع بنفسه من غير ضمّ ضميمة لا يكون تامّاً في موضوعيته للحكم، ولا يستفاد منه أنّ مع فقد هذا القيد وقيام قيد آخر مقامه ليس موضوعاً للحكم - : إنّ الكلام في تخصيص العام بالمفهوم المخالف راجع إلى الكلام في المطلق والمقيّد وتعارضهما؛ لأنّ قوله: «خلق الله الماء طهوراً»((3)) ظاهره أنّ تمام الموضوع في الطهورية هو الماء، ومفهوم قوله: «إذا کان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»((4)) عدم كون الماء تمام الموضوع لذلك الحكم، فكما أنّ في التعارض بين المطلق والمقيّد يؤخذ بظهور دليل المقيّد، لأنّه أقوى من المطلق في دلالته على كون تمام الموضوع مطلقاً وبدون القيد، كذلك في المقام ظهور الجملة في
ص: 406
المفهوم وعدم كون الموضوع بنفسه تمام الموضوع والملاك يكون أقوى من ظهور العامّ في ذلك، أي في كون تمام الموضوع والملاك العنوان المذكور في دليل العامّ.
ولا يخفى عليك: الفرق في المقام بين ما بنينا عليه في المفاهيم وحقّقناه من أنّ إتيان المتکلّم بقيد زائد في الكلام یدلّ على دخل هذا الزائد في موضوعية الموضوع للحكم، بمعنى عدم كونه موضوعاً للحكم مجرّداً وبدون القيد، وأمّا موضوعيته مع قيد آخر فلا مانع منه. ولا فرق في ذلك بين مفهوم الشرط، والوصف، والغاية، والعدد، وغيرها، وهذا هو الّذي يقتضيه التدبّر في كلمات القدماء. فعلى هذا، يكون باب تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف راجعاً إلى باب المطلق والمقيد؛ لأنّ العام یدلّ على أنّ تمام الموضوع للحكم، هو العلم مثلاً، والخاصّ أي المفهوم یدلّ على أنّ العلم وشيء آخر تمام موضوع الحكم.
وبين ما بنى عليه المتأخّرون حيث إنّ ملاك أخذ المفهوم على مختارهم دلالة القضیّة الشرطية مثلاً على علّية الشرط للجزاء على نحو العلّة التامّة المنحصرة، أو إشعار الوصف على العلّية هكذا، فلا مجال على مختارهم للقول بأنّ باب تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف راجع إلى باب المطلق والمقيّد، لأنّه لا دخالة للشرط في الموضوع، بل إنّما هو علّة للحكم. فلو دلّ دليل على «وجوب إكرام زيد» مثلاً، يكون معارضاً مع «إن جاءك زيد يجب إكرامه» على مذهبهم بخلافه على ما اخترناه، فإنّه لا دلالة للقضية الشرطية على أزيد ممّا ذكر. فنفي الحكم عن غير الموضوع المسكوت عنه في القضیّة إنّما يكون بالدليل على رأي المتأخّرين، ويكون الدليل الدالّ على ثبوت الحكم في غير الموضوع المسكوت عنه معارضاً للمفهوم، لكن على مختارنا ليست للقضيّة دلالة على نفي الحكم عن الموضوع المسكوت عنه في القضیّة، بل إنّما ينفى بالأصل، فتدبّر جيّداً.
ص: 407
ص: 408
هل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة يكون ظاهراً في رجوعه إلى خصوص الأخيرة،((1)) أو إلى کلّ منها؟((2))
والظاهر أنّ نزاعهم لا يكون في إمكان رجوعه إلى الكلّ وعدمه. كما أنّه لا إشكال في أنّ محلّ النزاع إنّما يكون فيما إذا كان المستثنى قابلاً لأن يستثنى من المستثنى منه، كما إذا كان المستثنى عنواناً ينطبق على بعض أفراد جميع العناوين المذكورة في الجمل المتعدّدة، أو كان فرداً يصدق عليه جميع العناوين الكليّة المذكورة.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ المحقّق الخراساني(رحمه الله) أفاد في المقام: بأنّه لا إشكال في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة؛ لأنّ رجوعه إلى غيرها من الاُولى والمتوسطة خارج عن طريقة أهل المحاورة. وكذلك لا إشكال في صحّة رجوع الاستثناء إلى الكلّ وإن كان المتراءى من صاحب المعالم(قدس سره) خلافه؛ وذلك من جهة أنّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى لا يوجب تفاوتاً في ناحية الأداة بحسب المعنى أصلاً، كان
ص: 409
الموضوع له في الحروف عامّاً أو خاصّاً، وكان المستعمل فيه الأداة - فيما كان المستثنى منه متعدّداً - هو المستعمل فيه فيما كان مستثنى منه - واحداً، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال. فعلى هذا، لا يصحّ التمسّك بأصالة العموم في الجملة الأخيرة فيما يشمله المستثنى، للقطع برجوع الاستثناء إليها ولو من باب القدر المتيقّن. وفي غيرها أيضاً لا مجال للتمسّك بأصالة العموم، لوجود ما يصلح للقرينية في الكلام. فلابدّ من الرجوع إلى الاُصول العملّية.((1))
هذا، والّذي ينبغي أن يقال: إنّه قد مرّ في أوّل الكتاب عند البحث في المعنى الحرفي((2)) أنّه ليس للشيئين المرتبطين إلّا وجودهما في الخارج، كالماء الّذي في الكوز، فليس في الخارج وجود مستقلّ إلّا وجود الماء ووجود الكوز، وأمّا كون الماء في الكوز فليس وجوداً مستقلّا في الخارج، بل يرى وجوده مندكّا في وجود المرتبطين أي الماء والكوز. نعم، ينتزع من كون الماء في الكوز نحو ارتباطهما إلى الآخر. فهذا الوجود الاندكاكي الّذي لا يرى في الخارج ولا يجيء في الذهن منه مفهوم مستقلّ، كما يجيء من لفظ الماء وغيره، هو الموضوع له للحروف، فالحروف إنّما وضعت لأجل إفادة ارتباط معنىً بمعنىً آخر، وهذا مطابق لما أفاده الرضيّ(قدس سره) من أنّه ليس للحروف معنى في الحقيقة.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّه لا إشكال في صحّة الاستثناء عن الجمل المتعدّدة إذا اعتبر كلّها شيئاً واحداً ويرتبط بالمستثنى؛ لأنّ الاستثناء أيضاً نحو ارتباط بين المخرج والمخرج منه، وهو كون المخرج خارجاً عن المخرج منه، وكونه بحيث اُخرج منه
ص: 410
ذلك. كما أنّه لا إشكال في صحته إذا كان المستثنى منه متعدداً وكان لهما جامعاً يكون هو المستثنى منه.
وأمّا إذا كان کلّ واحد منها ملحوظاً مستقلّا، فلا يمكن أن يرتبط كل واحد منها بالمستثنى باستثناء واحد؛ لأنّ لکلّ واحد منها ارتباطاً خاصّاً بالمستثنى، فليس هذا إلّا من قبيل استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد.
والحاصل: أنّ الحقّ فيما هو الفارق بين الحروف والأسماء: أنّ الحرف وضع لإفادة الارتباط لا لمفهوم الارتباط وإفادة تصوّره، فإنّ هذا معنى اسمي، فوضع الحرف لإفادة ارتباط المرتبطين، بحيث يحصل بسببه تصوّر المرتبطين على نحو تحقّقهما في الخارج، ولا يمكن تصوير هذا المعنى إلّا مندكّاً في الغير. ولو تصوّرته مستقلّا لما أفاد ارتباط المرتبطين على النحو المذكور. فعلى هذا، لا يمكن استعمال الحروف مثل «إلّا» لإفادة ارتباط معنىً من المعاني مع معنىً آخر ومع معنى غيره. وعدم إمكان هذا أشدّ من عدم إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد؛ لأنّ في المقام حيث يكون المعنى مندكّاً في المرتبطين يكون القول بإمكان تصور المعاني المختلفة وجعل اللفظ علامة لها لا بنحو المرآتية، كما احتملنا هناك، أبعد من الصواب.
فتلخّص ممّا ذكرنا: عدم صحّة استعمال أداة الاستثناء لإفادة ارتباط أكثر من معنى واحد مع معنى آخر.
ولا يقاس تعدّد المستثنى منه بتعدّد المستثنى؛ لأنّ إفادة إرادة التعدّد من الأداة في جانب المستثنى إنّما تكون من جهة حرف العطف، وأمّا في طرف المستثنى منه فحرف العطف إنّما يفيد إثبات الحكم المذكور في الجملة الاُولى لسائر الجمل.
اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّه لا مانع من ملاحظة الارتباطات الواقعة بين المرتبطات المختلفة وجعل اللفظ علامة لها جميعاً، كما ذهب إليه الشافعي في الآية الشريفة:
ص: 411
﴿وَالَّذينَ يَرْمُونَ الْ-مُحْصَناتِ ثُمَّ لَ-مْ يَأتُوا ...﴾((1)) بإمكان ذلك؛((2)) لأنّ الألفاظ إنّما تكون علامات للمعاني، فكما أنّ في باب المشترك إذا استعمل لفظ مشترك تفهم منه إرادة جميع المعاني لكون هذا اللفظ علامة للجميع، إلّا إذا دلت القرينة على تعيين أحد المعاني دون غيره، كذلك في المقام لا مجال لتخصيص الاستثناء بالجملة الأخيرة إلّا مع وجود القرينة، وإلّا فهو راجع إلى الكلّ. وكلامه هذا وإن كان مخدوشاً بالنسبة إلى الجملة الأخيرة، لأنّ الاستثناء راجع إليها على كلّ حال - كانت القرينة موجودة على ذلك أم لم تكن قرينة أصلاً - إلّا أنّ أصل هذا الاحتمال ربما لا يكون بعيداً عن الصواب. ولكنّ الإنصاف أنّ التحقيق ما ذكرناه أوّلاً، وأنّ هذا الاحتمال خلاف التحقيق، فتدبّر.
ص: 412
الحقّ جواز التمسّك بخبر الواحد المعتبر بالخصوص لتخصيص الكتاب، وإن كان ربما يستدلّ لعدم الجواز بوجوه ذكرها في الكفاية.((1))
أحدها: كون الكتاب قطعيّ السند والخبر ظنيّ السند، ولا يعقل صحّة القول بتخصيص ما هو القطعيّ بالظنيّ.((2))
وثانيها: عدم دلالة دليل حجّية الخبر إلّا فيما لم يكن مخالفاً للكتاب، لأنّ مدرك حجّیته ليس إلّا الإجماع، والقدر المتيقّن منه ما لم يكن مخالفاً للكتاب.((3))
وثالثها: لزوم جواز إثبات النسخ بخبر الواحد أيضاً؛ لأنّ النسخ قسم من التخصيص، فإنّه يخصّص العموم - في دلالته على جميع الأزمان - ببعض الأزمنة، والخاصّ يخصّصه ببعض الأفراد ويوجب التصرّف فيه بالنسبة إلى العموم الأفرادي.((4))
ص: 413
رابعها: الأخبار الدالّة على وجوب طرح الخبر المخالف للقرآن.((1)) وهي كما يظهر من تتبّع مواردها على وجوه:
الأوّل: مایدلّ على طرح الخبر الّذي لم يكن له شاهد أو شاهدان من كتاب الله تعالى.((2))
وهذا بظاهره مخالف لحجّية الخبر مطلقاً ولو لم يكن في مقابله عموم الكتاب؛ لأنّ ظاهره عدم وجود مقتضي الحجّية في الخبر بنفسه، وعند ضمّ شاهد أو شاهدين من كتاب الله تعالى فالحجّة إنّما يكون كتاب الله تعالى لا الخبر.
الثاني: الأخبار الواردة لعلاج الخبرين المتعارضين ووجوب الأخذ بما كان موافقاً للكتاب وطرح المخالف.((3))
الثالث: ما یدلّ على عدم صدور خبر مخالف للكتاب عنهم(علیهم السلام).((4))
الرابع: ما یدلّ على لزوم عرض الأخبار على الكتاب، فإن وافقته يجب أخذها، وإلّا يجب طرحها.((5))
واستدلّ لجواز التمسّك بخبر الواحد في مقابل عموم الكتاب بالسيرة المستمرّة من
ص: 414
زمان الأئمة(علیهم السلام) إلى زماننا هذا من جميع العلماء والأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب. ولو قلنا بعدم جواز ذلك لانسدّ باب الفقه والاستنباط في جلّ الأحكام، ولزم تعطيل عمدة الأحكام؛ لأنّه ما من رواية إلّا وفي قبالها عموم من الكتاب وإن كان من قبيل قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾.((1))
وأمّا الجواب عن الوجوه الّتي تمسّكوا بها لإثبات عدم الجواز، فيرد على الأوّل: أنّ الكتاب وإن كان سنده قطعياً إلّا أنّ دلالته لا تكون قطعية، فلابدّ من فهم المرادات منه من إعمال الاُصول العقلائية، كأصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدّية، وهذه الاُصول إنّما تجري إذا لم تكن على خلافه قرينة وإلّا فيعمل بالقرينة، وخبر الواحد المعتبر قرينة على عدم تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدّية في عموم الكتاب.
وكون سنده ظنّياً لا يكون مانعاً من قرينيته بعد دلالة الدليل على حجّيته وإلغاء احتمال الخلاف بالنسبة إليه، فهو لا يكون إلّا كالخبر المقطوع الصدور.
ويرد على الثاني: أنّ دليل حجّية خبر الواحد ليس الإجماع حتى يقال بقيامه على ما لم يكن مخالفاً للكتاب ولو كانت مخالفته على نحو العموم والخصوص، بل دليل حجّیته بناء العقلاء وطريقتهم على الأخذ بالخبر الموثّق، والشارع قد أمضى ذلك، كما حقّقنا في محلّه بأنّ حجّیته ليست تأسيسية، بل الشارع قرّر وأمضى هذه السيرة المستمرّة العقلائية الّتي يحتجّ بها المولى على عبده لو خالف أمره الّذي أخبره به مخبر موثّق مثلاً.
ويرد على الثالث (وهو لزوم جواز إثبات النسخ بخبر الواحد لو قلنا بجواز تخصيص العامّ به):
بأنّ الفارق قيام الإجماع على عدم جواز النسخ به؛ وإن لم يثبت هذا الإجماع فلا مانع من الالتزام به.
ص: 415
ويرد على الرابع (وهو دلالة كثير من الأخبار على وجوب طرح كلّ خبر مخالف للكتاب): بأنّ الطائفة الاُولى من هذه الأخبار لو فرضنا حجّيتها، فهي مع عدم تجاوزها من حديثين معارضة بأخبار كثيرة دالّة على وجوب الأخذ بالروايات، وإمضاء الشارع بناءَ العقلاء واستقرار سيرتهم على الأخذ بما أخبر به المخبر الموثّق؛ لأنّ هذه الطائفة إنّما تدلّ على عدم حجّية الخبر مطلقاً إلّا إذا كان له شاهد أو شاهدان من كتاب الله.
وأمّا الطائفة الثانية، فلا ربط لها بمحلّ الكلام؛ لأنّها واردة لأجل علاج التعارض الواقع بين الخبرين.
وأمّا الطائفة الثالثة، فمضافاً إلى إمكان أن يكون المراد بالمخالف ما كان مبايناً، يحتمل قويّاً أن يكون راجعاً إلى الأخبار المرويّة عنهم في اُصول الدين.
وأمّا الطائفة الرابعة، فليس دلالتها أزيد من لزوم طرح رواية لا توافق الكتاب ولا تلائمه، وأمّا الرواية الّتي تكون بينها وبين الكتاب ملائمة ولو كانت على نحو العموم والخصوص، فلا يجب طرحها.
والحاصل: أنّه بعد العلم باستقرار سيرة جميع المسلمين وأصحاب الأئمّة(علیهم السلام) في جميع أبواب الفقة على الأخذ بخبر الواحد ولو كان على خلافه عموم الكتاب لا مجال للتمسّك بهذه الروايات، فلابدّ من طرحها أو حملها على ما لا ينافي ذلك.
ص: 416
الفصل الثالث عشر: أحوال العامّ والخاصّ المتخالفين((1))
لا يخفى عليك اختلاف أحوال العامّ والخاصّ. فتارة: يكون الخاصّ مقارناً مع العامّ، فيكون مخصّصاً للعامّ وبياناً له.
واُخرى: يكون متأخّراً عنه، فإن كان صدوره بعد حضور وقت العمل بالعامّ بالنسبة إلى هذا الفرد، فيكون ذلك الخاصّ ناسخاً والعامّ منسوخاً. وإن كان قبل حضور وقت العمل، يكون الخاصّ مخصّصاً. وإن كان الخاصّ من جهة صدوره قبل وقت العمل أو بعده مجهول التاريخ مع العلم بتأخّره عن العامّ، فعدم محكومية هذا الفرد بحكم العامّ فعلاً مقطوع - كان الخاصّ المذكور فيه هذا الفرد ناسخاً أو مخصّصاً للعامّ -.
وثالثة: يكون صدور الخاصّ مقدّماً على العامّ، فإن كان صدور العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ يكون العامّ ناسخاً له. وإن كان قبل حضور وقت العمل به يكون الخاصّ مخصّصاً، وقرينةً على عدم كون العموم مراد المولى بحسب إرادته الجدّية.
ص: 417
ورابعة: يكون کلّ منهما مجهول التاريخ بحسب الصدور، فلا يمكن تقديم أحدهما على الآخر، ولابدّ من الرجوع إلى الاُصول العملية.
هذا تمام الكلام في المباحث الراجعة إلى العامّ والخاصّ.
والحمد لله على الاختتام، وعليه التوكّل وبه الاعتصام، والصلاة على خير خلقه وآله أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يجعل عواقب اُمورنا خيراً، وأن يوفّقنا لما يحبّ ويرضى.
ص: 418
وفیه اُمور:
الأمر الأوّل: في تعريف المطلق والمقيّد
الأمر الثاني: في ملاك الإطلاق والتقييد
الأمر الثالث: في ألفاظ المطلق
الأمر الرابع: في اعتبارات الماهيّة وتقسيمها
الأمر الخامس: في إحراز الإطلاق إثباتاً
ص: 419
ص: 420
قد عُرّف المطلق: بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه.((1))
وقال في الكفاية: بأنّه قد أشكل عليه بعض الأعلام بعدم الاطّراد والانعكاس.((2)) وقد ذكرنا مراراً أنّ هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية وما يقع في جواب السؤال عن «ما» الحقيقية، وإنّما تكون تعاريف لفظية بسببها يشير المتکلّم إلى ما هو الموجود في الذهن.((3))
ولكن لا ينبغي لنا الاكتفاء بهذا الكلام في المقام، بل لابدّ من معرفة الإطلاق والتقييد وموارد إطلاقهما، فنقول:
أمّا تعريفهم بأنّ المطلق ما دلّ على شائعٍ في جنسه، فإمّا أن يكون المراد أنّ المطلق ما له أفراد متعدّدة بأن يكون الشيوع والتكثر بحسب الأفراد. وبعبارة اُخرى: يكون كلّياً يصدق على أفراده المتكثّرة، والمقيّد ما لم يكن كذلك.
فمن الواضح عدم إفادة هذه العبارة هذا المعنى؛ ولو قيل بأنّ المطلق ما دلّ على شائع في أفراده لكان أولى.
ص: 421
وإمّا أن يكون مرادهم من هذا التعريف أنّ المطلق ما له أفراد متعدّدة وشائع في أفراده ويكون صدقه على جميع أفراد طبيعة واحدة على سبيل البدلية على السواء. وبعبارة اُخرى: يكون صادقاً على فرد من أفراد الطبيعة الواحدة لا على نحو التعيين حتى يشمل أسماء الأجناس والنكرة وغيرهما؛ ولذلك قالوا: إنّ المطلق ما دلّ على شائع في جنسه لا في أفراده.
ففيه: أنّ التعريف لا يفي لإفادة هذا أيضاً.
وعلى کلّ حال: ففي هذا التعريف مضافاً إلى أنّ ظاهره كون الإطلاق والتقييد راجعين إلى اللفظ ومن صفات الألفاظ دون المعاني، يلزم منه أن تكون المعاني الجزئية مثل معنى «زيد» و«الأفعال» من المقيّدات مع أنّ الظاهر عدم صحّة إطلاق المقيّد عليهما، وأن تكون المعاني الكلية مثل معاني «أسماء الأجناس» وكلّ ما هو موضوع لمعنى كلّي من المطلقات ولو لم يكن تمام الموضوع للحكم، فيصحّ إطلاق المطلق مثلاً على الرقبة المذكورة في قولنا: «أعتق رقبة مؤمنة» مع اتّفاقهم على عدم صحّة إطلاق المطلق عليها. وبناءً عليه يكون اللفظ مبايناً مع المقيّد فالمطلق غير المقيّد والمقيّد غير المطلق، ويكون بعض الألفاظ متّصفاً بالإطلاق دائماً وبعضها متّصفاً بالتقييد كذلك.
هذا، والّذي يقتضيه التحصيل وملاحظة كلمات الاُصوليّين والفقهاء وموارد إطلاقاتهم:((1)) أنّ الإطلاق والتقييد ليسا من صفات الألفاظ، بل ما يتّصف بهما ليس إلّا المعنى. ولا يكاد أن يوجد لفظ متّصف بالإطلاق دائماً ولفظ متّصف بالتقييد كذلك، بل ربما يتّصف لفظ بملاحظة معناه بالإطلاق تارة، وبالتقييد اُخرى، كما يمكن أن لا يكون متّصفاً بواحد منهما أصلاً، بل طبع اللفظ - كما سيتّضح - صالح
ص: 422
لأن يتّصف باعتبار المعنى بالإطلاق والتقييد، فلا يلزم أن يكون دائماً موصوفاً بأحدهما؛ ألا ترى أنّ لفظ «الرقبة» إذا لم يكن موضوعاً لحكم من الأحكام لا يصحّ إطلاق المطلق أو المقيّد عليه، وأمّا إذا كان مأخوذاً في موضوع حكم فتارة: يطلق عليه المطلق مثل الرقبة المذكورة في كفّارة اليمين، وتارة: يطلق عليه المقيّد كما في كفّارة قتل الخطأ، وربما يكون إطلاقه وتقييده مختلفاً فيه كما في كفّارة الظهار.
فعلى هذا، نقول: کلّ معنى من المعاني الّتى تكون لها الشياع والسريان ولو كان جزئيّاً، كالأعلام الشخصيّة والجزئيات الحقيقية، الّتي لا مانع من فرض الشياع والسريان فيها ولو كان بحسب الحالات والأزمنة والأمكنة، وكان موضوعاً لحكم من الأحكام بحيث يشمل هذا الحكم جيمع حالاته وأفراده، يكون مطلقاً.
وكلّ معنى كان له هذا الشياع والسريان وكان موضوعاً لحكم من الأحكام ولكن كان في موضوعيّته للحكم بحيث لم يشمل ذلك الحكم جميع أفراده أو حالاته لخصوصيّة لاحظها الحاكم في موضوعه، يكون مقيّداً.
وقد اتّضح ممّا ذكرنا في المقام أوّلاً: أنّ النزاع في المقام ليس واقعاً في لفظ المطلق والمقيّد وما هو بالحمل الأوّلي الذاتي مطلق ومقيّد، بل النزاع واقع فيما هو بالحمل الشائع الصناعي مطلق أو مقيّد ويحمل عليه بهذا الحمل المطلق أو المقيّد.
وثانياً: أنّه ليس لنا ألفاظ مخصوصة مطلقة وألفاظ مخصوصة مقيّدة، بحيث لا يمكن تطوّر الإطلاق في المقيّد والتقييد في المطلق، حتى يكون کلّ من المطلق والمقيّد قسماً من الألفاظ كالاسم والفعل والحرف، ولذا يتّصف لفظ واحد تارة بالإطلاق واُخرى بالتقييد كما مرّ.((1))
ص: 423
وثالثاً: أنّ إطلاق المطلق والمقيّد على الألفاظ إنّما هو باعتبار المعنى وبالعرض لا باعتبار نفس ذاتها. وسيظهر لك((1)) أنّ اتّصاف المعاني بهما ليس باعتبار ذواتها.
ورابعاً: أنّ الإطلاق عبارة عن: تساوي جميع أفراد مفهوم في موضوعيته للحكم. والتقييد عبارة عن: عدم تساوي أفراده في الموضوعية.
وقد ظهر أيضاً كون الإطلاق والتقييد من الاُمور الإضافية. وكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
ص: 424
بعدما عرفت معنى الإطلاق والتقييد، فاعلم: أنّ ما هو ملاك الإطلاق والتقييد على ما يظهر من عباراتهم ملاحظة الشياع والسريان في المعنى وعدمها. فإذا لوحظ في الماهية شياعها وسريانها في أفرادها تكون مطلقة. وإذا لوحظت مع ضمّ شيء إليها تكون مقيّدة.
ولا يخفى ما فيه: فإنّ الشياع والسريان لازم المعنى وذاتيّ الماهية، فلا يعقل دلالة اللفظ عليه تارة وعدمها اُخرى.
فما هو الملاك في إطلاق اللفظ والمعنى ليس إلّا ملاحظة الحاكم معنىً من المعاني تمام موضوع حكمه، بحيث لا يحتاج شموله لجميع أفراده إلى ضمّ ضميمة مثل «رقبة» في قولنا: «أعتق رقبة». والملاك تقييدهما لحاظه مع ضمّ ضميمة إليه كقوله: «أعتق رقبة مؤمنة»، فإنّ عتق الرقبة لا يكون تمام موضوع حكمه مطلقاً، بل إذا كانت متّصفة بصفة الإيمان.
وبالجملة: لا ريب في أنّ المفاهيم الّتي لها شياع وسريان مثل النكرة كرجل، واسم الجنس نحو الرجل، تارة: تكون في موضوعيّتها للحكم بحيث يكون شمول الحكم لتمام أفرادها على السواء مثل: «أعتق رقبة»، واُخرى: لا تكون كذلك مثل: «أحلّ الله
ص: 425
البيع»، فإنّ هذا الحكم ليس ثابتاً لجميع أفراد البيع، فبعض أفراده مثل «بيع المجهول» يكون خارجاً عن هذا الحكم ولا يشمله هذا الحكم.
وإنّما الخلاف في أنّ الملاك والمناط الّذي به يكون تارة نسبة الحكم إلى جميع أفراده على السواء، واُخرى لا يكون كذلك هل هو أنّ الآمر لاحظ الشياع والسريان الموجود في موضوع الحكم ولحاظه هذا هو العلّة لتساوي نسبة جميع الأفراد إلى الحكم، وعدم لحاظه كذلك سبب لافتراق نسبة الأفراد إلى الحكم، أو أنّ ملاك تساوي الأفراد لحاظ الموضوع مقيّداً بالشياع والسريان، وملاك عدمه عدم تقيّده بذلك؟
فلا ريب في عدم كون الوجه الأخير هو الملاك. لأنّ الماهيّة مع لحاظ الشياع والسريان ومقيّدة بهذا القيد لا يمكن انطباقها على ما في الخارج.((1))
وأمّا الوجه الأوّل، ففيه: أنّ الشياع والسريان ذاتيّ لما من شأنه هذا، ولا يعقل أن يكون لحاظ ذلك دخيلاً في شياعه وسريانه، فمفهوم رجل يصدق على کلّ فرد من أفراده لوحظ فيه ذلك أم لا.
فالّذي ينبغي أن يقال: إنّ الملاك کلّ الملاك، كما يظهر بعد التأمّل في كلماتهم((2)) وإعطاء حقّ الدقّة فيها، ليس إلّا أنّ الحاكم - سواء كان من الحُكّام العرفيين أو الشرعيين - تارة يلاحظ مفهوماً من المفاهيم الّتي لها شياع وسريان في موضوع حكمه بحيث كان تمام مركب حكمه هذه الطبيعة ليس إلّا، ولا تكون موضوعيّتها للحكم مقيّدة بقيد تكون نسبة تمام أفراد هذه الطبيعة بالنسبة إلى حكمه متساوية، واُخرى لم يلاحظه كذلك بل يلاحظ المعنى مقيّداً بقيد ومتخصَّصاً بخصوصية لا تكون نسبة
ص: 426
جميع أفراد الطبيعة إلى الحكم سواء؛ فالأوّل هو ملاك الإطلاق، والثاني ملاك التقييد. ألا ترى أنّ الفقهاء كما أشرنا إليه يقولون بتقييد الرقبة المذكورة في الآية في كفّارة قتل الخطأ، وبإطلاقها في كفّارة اليمين، واختلفوا في إطلاقها وتقييدها في الظهار، فهل تجد لهذا منشأً وملاكاً غير ما ذكرناه أو هل يصحّ أن يقال: إنّ الرقبة المذكورة في هذه الآيات الكريمة لا تدلّ بذاتها على الشياع والسريان؟
وأظنّ أنّ ما نسب إلى المشهور من أنّ المطلق ما لوحظ في معناه الشياع والسريان((1)) بمعنى تقييد المعنى بلحاظه كذلك، حتى يكون استعماله في المقيّد مجازاً من جهة إلغاء هذا القيد، وما نسب إلى السلطان(قدس سره) في مقام الجواب بأنّ المعنى ليس مقيّداً بقيد اللحاظ بل الموضوع له هو الماهية اللابشرط فلا يكون استعماله في المقيّد مجازاً.((2))
ليس في محلّه. بل لعلّ أن يكون مراد المشهور أنّ الشياع والسريان حيث يكون من ذاتيّات المعاني من غير دخل لحاظ تقيّده بذلك وعدمه فيه يكون استعمال المطلق في المقيّد مجازاً؛ لأنّه موجب لإلغاء الشياع والسريان الّذي يكون في المعنى، ويصير من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ وهو الرقبة المقيّدة بخصوصية زائدة، فأجاب السلطان(قدس سره) عنهم بأنّ هذا يتّجه إذا استعمل الرقبة في الرقبة المؤمنة من غير ذكر المؤمنة في الكلام، وأمّا إذا استعمل الرقبة في معناه الّذي له الشياع والسريان وبيّن تقيّدها بالإيمان بدالّ آخر كما في قولنا: «أعتق رقبة مؤمنة» حتى يكون من باب تعدّد الدالّ والمدلول فلا يكون موجباً للمجاز، كما لا يخفى.((3))
ص: 427
فتحصل ممّا ذكرنا في ملاك الإطلاق والتقييد: أنّ اتّصاف المعاني بهما ليس باعتبار نفس ذواتها. وبتعبير آخر: لا تكون صفة بحال الموصوف، بل صفة بحال متعلّق الموصوف؛ لأنّ المعنى تارة: يؤخذ موضوعاً للحكم ويكون تمام أفراده بالنسبة إليه في الموضوعية على السواء، وتارة: لا يكون كذلك، فالأوّل هو المطلق والثاني المقيّد.
وبعبارة اُخرى: موضوع الحكم إذا كان في موضوعيته للحكم مطلقاً يتّصف المعنى الّذي لوحظ موضوعاً له بالإطلاق، وإلّا فيتّصف بالتقيّد، فتدبّر.
ص: 428
قد ظهر لك ممّا حقّقناه أنّ إطلاق المطلق على اللفظ ليس من جهة وجود خصوصية في معناه الموضوع له حتى لا يتّصف بالإطلاق ما ليست له هذه الخصوصية. وبعدما حقّقناه في المقام لا نحتاج إلى ما تعرّض إليه في الكفاية((1)) لبيان بعض الألفاظ الّتي يطلق عليه المطلق وغيرها، لأنّه على ما اخترناه أجنبيّ عن المقام. ومع ذلك نذكرها تبعاً له(قدس سره).
فمنها: اسم الجنس، كإنسان ورجل وبقر وفرس وحيوان وسواد وبياض وغيرها. وأفاد بأنّها موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة من غير ملاحظة شرط معها حتى ملاحظة إرسالها وإبهامها كذلك. وهذا ما يعبّر عنه باللابشرط المقسمي، فلا تكون موضوعة لمفاهيمها بشرط لحاظ شيء معها حتى تكون موضوعة للماهية بشرط شي ء، ولا موضوعة لمفاهيمها مع عدم لحاظ شيء معها حتى تكون موضوعة للماهية بشرط لا، ولا تكون أيضاً موضوعة للماهية اللابشرط القسمي؛ لأنّه كلّي عقلي لا موطن له إلّا الذهن.
هذا، ولكنّه لو لم يأت بهذه الاصطلاحات وقال بأنّ الموضوع له في أسماء الأجناس
ص: 429
إنّما يكون ذوات المفاهيم من غير دخل شيء فيه حتى الوجود والعدم وما ينتزع منه كالشيئية والصفات العارضة له باعتبار وجودها، لكان أولى.
ومنها: علم الجنس، كاُسامة. والمشهور وإن كان أنّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعيّنة في الذهن،((1)) ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أدات التعريف. ولكنّ الحقّ عدم كونه موضوعاً للماهية المقيّدة بقيد حضوره في الذهن والتعيين الذهني؛ لأنّ تعيّن الماهية ليس دائراً مدار ذلك بل هي متعيّنة، ولا دخالة لأخذ هذا القيد - أي قيد تعيّنها في الذهن - في تعيّنها الماهوي، فهي متعيّنة لوحظ معها هذا أم لا. مضافاً إلى أنّه لو كان موضوعاً للماهية مع هذا القيد لما يصدق على الأفراد. ولا يمكن حمله على الخارجيات إلّا بالتجريد عن هذه الخصوصية والحال أنّه يستعمل في الأفراد بدون تصرّف ولا تأويل. هذا، مع أنّه ممّا لا يلائمه حكمة الوضع.
وأمّا كون علم الجنس معرفة بخلاف اسم الجنس، فهو فرق لفظي ولا يلزم منه الفرق بحسب المعنى كما هو الحال في المؤنّثات السماعية.
ومنها: المفرد المعرَّف باللام. وهو على قسمين: تارة يطلق على حصّة من الحقيقة الّتي تكون معهوداً بين المتکلّم والمخاطب لتقدّم ذكر تلك الحصّة بالصراحة أو الكناية، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾،((2)) أو لعلم المخاطب به بالقرائن نحو «خرج الملك»، أو لحضور هذا الفرد مثل «هذا الرجل»، وهذا هو الموسوم بالعهد الذكري والعهد الحضوري.
وتارة اُخرى: يطلق اسم الجنس المعرّف باللام على نفس الحقيقة، فإمّا لا يكون
ص: 430
النظر إلّا إلى نفس الحقيقة مع قطع النظر عن مصاديقها، وإمّا أن يطلق على الحصّة المعيّنة منها، وإمّا أن يطلق على الحصّة غير المعيّنة، وإمّا أن يطلق على کلّ الأفراد. فاللام في الأوّل تسمّى بحقيقة الجنس، وفي الثاني بالعهد الخارجي، وفي الثالث بالعهد الذهني، وفي الرابع بالاستغراق.
وكيف كان، فلا إشكال في تعريف المفرد المعرّف باللام بحسب اللفظ. وقد صار أهل الأدب في مقام إرجاع ذلك إلى خصوصية ملحوظة في المعنى، فقال بعضهم: إنّ اللام موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني.
وفيه: ما ذكرناه في عَلَم الجنس من أنّ ذلك القيد لا يفيد التعيين، بل الملاك في التعيين صحّة حمل المعيّنية بالحمل الشائع الصناعي عليه. وهذه صادقة على مفاهيم أسماء الأجناس، وما هو مدخول لام التعريف. ولا فائدة لهذا القيد غير أنّه مانع لصدق المفهوم على الخارجيات.
وذهب بعضهم:((1)) إلى أنّ وجه التعريف كون اللام موضوعة للإشارة فإذا اُطلق المفرد المعرّف باللام على نفس الحقيقة يشار بها إليها، وكذلك إذا اُريد منه الاستغراق، أو غيره. فالتعريف إنّما يجيء من قبل الإشارة.
وفيه: أنّه على هذا يجب أن لا يصحّ استعمال «هذا الإنسان»، لأنّه يلزم منه إشارتان (من هذا، واللام)، مع أنّ هذا الاستعمال كثير في كلام العرب.
والظاهر أنّه لا فرق بين اسم الجنس المعرّف باللام وبين اسم الجنس غير المعرّف إلّا من جهة التنكير والتعريف اللفظي. فاسم الجنس لابدّ أن يستعمل مع اللام، أو
ص: 431
بدونها مع التنوين، وبدونهما مع الإضافة كغلام زيد، فإنّه مستعمل في نفس مفهومه بما هو هو، وخصوصيته في المقام إنّما تفهم من دالّ آخر وهو إضافته إلى زيد.
وأمّا أنّ اللام في جميع الموارد يكون للتزيين، كما زعمه في الكفاية.((1))
ففيه: إنّما يكون للتزيين ويفيد الزينة إذا كان العَلَم الّذي عليه اللام صفة من الصفات، كالحسن والحسين. فدخول اللام عليه كأنّه يشير إلى المعنى الأصلي، وأنّه جعل هذا اللفظ علماً لهذا الشخص من جهة أنّه موصوف بتلك الصفة.
وكذلك الجمع المعرّف باللام، فدلالته على العموم ليست من قبل اللام، ولأجل دلالة اللام على تعيين المرتبة المستغرقة لجميع الأفراد،((2)) بل إنّما یدلّ على الاستغراق من دون توسيط دلالة اللام على التعيين.
وأمّا ما أفاد في الكفاية من تعيّن المرتبة الاُخرى وهي أقلّ مراتب الجمع إذا لم تكن دلالته على المرتبة المستغرقة مستنداً إلى الوضع.((3))
ففيه: أنّه لا مجال لدلالته على القدر المتيقّن؛ لأنّ المتکلّم إذا لاحظ تمام ما يصلح له المفهوم وألقى اللفظ الدالّ عليه، مثل «مردها» بالفارسية، فلا مجال لأخذ القدر المتيقن، بل لفظه الملقى ظاهر في جميع الأفراد والمراتب، إلّا أن یدلّ عليه دليل من الخارج، وقد ذكرنا ذلك في صدر مبحث العامّ والخاصّ.
وملخّص الكلام: أنّ القول بكون اللام موضوعة للماهية والحقيقة بقيد تعيّنها في الذهن، أو موضوعة للإشارة إلى مدخولها، أو أن يكون للمفرد المعرّف وضع خاصّ بسببه یدلّ على معنى خاصّ غير ما هو مفاد الأسماء الموضوعة للمعاني الكلّية، ممّا لم
ص: 432
نقف على دليله. فعلى هذا، استفادة الخصوصيات إنّما تكون من قبل الخصوصيات الحالية والمقالية الّتي تكون موجودة في كلام أهل المحاورة.
ومنها: النكرة، مثل «رجل» في «جاء رجل» وقولك: «جئني برجل». ويظهر من المحقّق القمّي(رحمه الله) كون مفادها كلّياً، لأنّ اللفظ موضوع لمفهوم كلّي فإذا جاء في الكلام منكراً يفيد ضمّ قيد الوحدة إليه، وهو أيضاً كلّي.((1)) وأمّا رجل في قولك: «جاء رجل» فهو اُطلق في الفرد المعيّن خارجاً والمجهول عند المخاطب.
وصاحب الفصول(رحمه الله) ذهب إلى كونها جزئيّاً حقيقيّاً من جهة أنّ النكرة تدلّ على أحد الأفراد المردّد بينها،((2)) كما هو الأمر في متعلّق العلم الإجمالي، فعلمك بالإجمال بأنّ إناء زيد نجس أو إناء عمرو لا يصير سبباً لكون متعلّق العلم كلّيا، وفيما نحن فيه لو قال: «جئني برجل» فمجيئك بالرجل وإن كان يصدق على هذا وعلى هذا، وهذا بحيث لاحظ الآمر جميع هذه الأفراد ولكن بالنسبة إلى کلّ فرد منها كأنّه لاحظ المجيء تارة ولم يلاحظه اُخرى، فتارة يجيء لحاظه في الذهن. ويذهب تارة اُخرى.
والمحقّق الخراساني بعد ما أفاد بأنّ المفهوم في المثال الأوّل هو الفرد المعين ولو بنحو تعدّد الدالّ والمدلول، أفاد بأنّ صحّة حمل رجل في «جئني برجل» على کلّ فرد من الأفراد مع عدم صدقه على هذا الفرد أو غيره على سبيل الترديد، كما اختار صاحب الفصول(رحمه الله)، دليل على كليّة معنى النكرة. كما أنّ صدق الامتثال والإتيان بالمأمور به - لو أتى کلّ واحد من المكلّفين بالمأمور به مع كونه نكرة - عليه، دليل آخر على كليّة معناها.((3)) وهذا كلام متين.
ص: 433
نعم، يمكن أن يقال: إنّ اللاحظ حيث يرى الحصّة والطبيعة بقيد الوحدة باعتبار الوجود، فيرى وجوداً واحداً مردّداً بين كثيرين، وتردّد هذا الواحد الجزئي بين الأفراد لا يخرجه عن جزئيته، ولا يصير بذلك كلّياً، كما أنّ الإنسان إذا رأى شبحاً من بعيد وتردّد في أنّه إنسان أو حيوان أو زيد أو عمرو لا يخرجه ذلك التردّد عن الجزئية.
ولكن لا يخفى ضعف هذا أيضاً؛ لأنّ مع هذا التوجيه لا يصير الكلّى جزئيّاً، ولا يصير ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين - وهو الفرد المردّد والشبح في المثال - ممّا يمتنع فرض صدقه على كثيرين.
وكيف كان، لا فائدة عملية في تعقيب ذلك. كما أنّه لا فائدة في معرفة أنّ اسم الجنس المعرّف باللام دلالته على کلّ واحد من المعاني الّتي يراد منها هل هي من جهة وضع اللام أو المفرد المعرّف أو يستفاد من الخصوصيات الخارجية؟
وما ينبغي أن نقول هنا: إنّ ملاك صدق الأحكام على الموضوعات الّتي يعبّر عنها في المعقول بالمصاديق تارة: يكون الطبيعة من غير ملاحظة وجودها. واُخرى: يكون الطبيعة لكن مع لحاظ وجودها. وثالثة: يكون الطبيعة مع لحاظ تمام الوجودات المندرجة فيها، بحيث تجعل الطبيعة مرآة ويرى منها جميع الأفراد بالإجمال، فإذا كان ملاك صدق الحكم على الموضوع كون الطبيعة ملحوظة ومقصودة من غير أن يكون نظره إلى الوجودات بحيث كان مركب الحكم نفس الطبيعة، أو كان نفس الطبيعة لكن باعتبار وجودها الخارجي المردد بين وجوداتها بحيث كان مركب الحكم هذا الوجود الخارجي المردّد، يكون مركب الحكم مطلقاً ويصح إطلاق وصف المطلق عليه، فلا ارتباط لما ذكره في الكفاية بما ذكرناه في المقام.
ومن هنا ظهر الفرق بين العامّ والمطلق؛ فإنّ في العامّ إنّما يكون ملاك صدق الحكم على الموضوع ملاحظة الحاكم المعنى الّذي جعله مركباً للحكم مرآةً لجميع أفراده بحيث تكون الطبيعة آلةً لملاحظة جميع الأفراد والوجودات، بخلاف المطلق.
ص: 434
لا يخفى عدم ارتباط ما نحن فيه بما ذكره علماء المعقول من اعتبارات الماهية((1)) في المباحث المتعلّقة بها، ولكن حيث أشار المحقّق الخراساني(قدس سره) وغيره من الاُصوليّين إليها، وإلى الإشكال المذكور في كتب المعقول وهو: دخول المقسم في الأقسام، فلا بأس ببيان ما هو الحقّ في المقام وإن كان خارجاً عمّا نحن بصدده، فنقول:
إعلم: أنّ أهل المعقول في مقام تعيين الماهية الّتي يحمل عليها الكلّي أفادوا بأنّ الماهيّة قد تعتبر وتلاحظ بشرط أن يكون معها شيء، وهي الماهية المخلوطة وبشرط شيء.
وقد تعتبر بشرط عدم اقترانها مع شيء، وهي الماهية المجرّدة وبشرط لا. وحيث اعتبر تجرّدها عمّا عداها فلا وجود لها حتى في الذهن.
لا يقال: إذا كان كذلك، أي لا وجود لها حتى في الذهن، فكيف تكون من الاعتبارات الذهنية؟
لأنّه يقال: هذا نظير شبهة المعدوم المطلق، والمجهول المطلق، وبيانه: أنّ المعدوم
ص: 435
المطلق إذا كان يمتنع الحكم عليه، فكيف يحكم عليه بامتناع الحكم عليه مع أنّ الحكم متوقّف على تصوّر الموضوع والمحمول، وكلّ ما يتصوّر في الذهن فهو موجود ولابدّ أن يحكم عليه بالإمكان لا بالامتناع؟ وهكذا المجهول المطلق؛ إذ لا يمكن أن يخبر عنه، فكيف يخبر عنه بعدم إمكان الإخبار عنه؟
والجواب: أنّ الحاكم في حكمه على المعدوم المطلق بامتناع الحكم عليه، والمخبِر في إخباره عن المجهول المطلق بعدم إمكان الإخبار عنه يكون غافلاً عن تقرّره في الذهن وتحقّقه في عالم الذهن، ويشير بسبب هذا الّذي في ذهنه - وله نورانية ضعيفة - إلى ما يكون ظلمة بحتاً وعدماً صرفاً.
والإشكال المتوهّم في المقام إنّما يكون نظير هذا الإشكال، ببيان: أنّ الماهية المعتبرة فيها عدم وجود شيء معها إذا لم يمكن تحقّقها لا في عالم الخارج ولا في عالم الذهن كيف تصير ملحوظة ومعتبرة مع أنّ اعتبارها لا يمكن إلّا بوجودها في الذهن؟
وجوابه: أنّ المعتبِر يعتبر الماهية بشرط لا ويشير بسبب ما تصوّره ولاحظه إلى الماهيّة الّتي لا يحكم عليها ويكون غافلاً حين الاعتبار عن تقرّرها في الذهن وتحقّقها فيه.
وقد تعتبر الماهية مطلقة ومن غير تقيّدها بقيد عدم شيء معها أو وجود شيء معها، وهذه الماهية المطلقة واللابشرط، وهي الّتي يحمل عليه الكلّي الطبيعي ويعرضها.
وقد اختلفوا في وجودها وعدمها، فذهب بعضهم: إلى عدم إمكان وجودها.
وذهب أكثرهم: إلى أنّها موجودة؛ لأنّ الماهية المخلوطة وبشرط شيء إذا كانت موجودة في الخارج فلابدّ أن تكون هذه أيضا كذلك، فإنّ الماهية اللابشرط يجتمع مع ألف شرط، فهى موجودة مع بشرط شيء.
ولا يخفى عليك: أنّه لا يكون واحد من هذه الأقسام مقيّداً باللحاظ والاعتبار وإلّا يمتنع وجوده إلّا في الذهن.
ص: 436
وقد اُشكل على تقسيم الماهية بهذه الأقسام بلزوم دخول المقسم في الأقسام؛ لأنّ المقسم ليس إلّا ذات الماهيّة لا بشرط وجود شيء معها ولا بشرط عدم وجود شيء معها وهذه ليست إلّا الماهية الّتي اعتبرت عدم تقييدها باقتران شيء معها وعدمه.
وأجاب بعضهم عن هذا الإشكال:((1)) بأنّ المقسم إنّما هو ذات الماهية لا بشرط الاقتران ولا بشرط عدم الاقتران، والقسم هو الماهية المقيّدة بقيد عدم تقيّدها بلحوق شيء إليها وعدم لحوق شيء بها. فعلى هذا، يكون المعروض للكلّي هو الماهيّة اللابشرط المقسمي((2)) دون القسمي.
ولكنّ الحقّ في مقام الجواب أن يقال: إنّ هذا التقسيم كما يستفاد من عبائرهم مثل قولهم: «إنّ الماهية تعتبر، أو تلاحظ، أو اعتبارات الماهية» إنّما يكون راجعاً إلى اعتبار الماهيّة، فالمقسم هو اعتبار الماهية ولحاظها، فلا يكون داخلاً في الأقسام. وعلى هذا الجواب يكون المعروض للكلّي وما يحمل عليه، هو الماهية اللابشرط القسمي.((3))
فتلخّص ممّا ذكر أنّ أهل المعقول في مقام تعيين الماهية الّتي يحمل عليها الكلّي أفادوا بأنّ الماهية تارة: تعتبر بشرط لا، وهذه لا يمكن أن يحمل عليها الكلّي. واُخرى: تعتبر بشرط وجود شيء معها، فهذه أيضاً لا يمكن حمل الكلّي الطبيعي عليها. وثالثة: تعتبر لا بشرط أي بدون تقيّدها بالمتشخّص وعدمه، فهذه هي الماهية الّتي يعرضهاالكلّي وتسمّى بالكلّي الطبيعي.
ص: 437
ص: 438
قد ظهر ممّا حقّقناه في الأمر الأوّل والثاني حال المطلق والمقيّد بحسب مقام الثبوت. وأمّا بحسب مقام الإثبات، فاعلم: أنّه لا مجال للتمسّك بأصالة الحقيقة((1)) لو شكّ في الإطلاق والتقييد؛ لأنّ التمسّك بها يصحّ لو كان استعمال اللفظ في المقيّد مجازاً، وأمّا بعد فرض عدم ذلك فلا مجال له.
وقد أفاد المحقّق الخراساني(رحمه الله) احتياج إثبات الإطلاق إلى المقدّمات الثلاثة المعروفة المعبّر عنها في الاُصول بمقدّمات الحكمة؛ لأنّ ملاك الإطلاق والتقييد عنده: لحاظ شياع المعنى وسريانه في تمام الأفراد وعدم لحاظه كذلك إلّا في بعض الأفراد، فلا موضوع للحكم إلّا الأفراد.
وعليه لابدّ لاستفادة الإطلاق من الكلام أوّلاً: من إثبات كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده وما هو موضوع حكمه، لا الإهمال والإجمال.
وثانياً: من انتفاء ما يوجب التعيين والتقييد.
وثالثاً: عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب حتى يكون نسبة کلّ واحد من
ص: 439
الأفراد في موضوعيّته للحكم على السواء، ولا يكون بعضها في موضوعيّته للحكم متيقّناً ومقطوعاً عند المخاطب والباقي في موضوعيته محتملاً.
فلو انتفى المقدّمة الاُولى بأن احتمل كونه في مقام الإهمال والإجمال لا مجال للتمسّك بالإطلاق.
وهكذا الحال بالنسبة إلى المقدّمة الثانية.
وأمّا المقدّمة الثالثة، فانتفاؤها أيضاً موجب لعدم تمامية الإطلاق؛ لأنّه لو كان موضوعية بعض الأفراد مقطوعاً ومعلوماً عند المخاطب وكان هذا البعض تمام موضوع حكمه لما أخلّ بغرضه لو لم يأت في كلامه بما يفيد ذلك ولما كان منافياً لكونه في مقام البيان؛ لأنّه إنّما يكون في مقام بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه وما هو بالحمل الشائع تمام الموضوع، لا في مقام بيان أنّه، تمام موضوع حكمه، وهذا إذا كان القدر المتيقّن موجوداً بحسب مقام التخاطب، كأن تكون في ذهن المخاطب خصوصيات توجب التفاته إلى هذا المتيقّن وقطعه بموضوعيّته للحكم.
وأمّا إذا كان وجود القدر المتيقّن بحسب غير مقام التخاطب، كما لو تأمّل ولاحظ بعض الجهات علم بتيقّن بعض الأفراد دون غيره، فليس مضرّاً بالإطلاق كما لا يخفى.((1))
ولا يخفى عليك: أنّ مورد الشكّ في الإطلاق والتقييد إنّما يكون فيما إذا لم تكن قرينة دالّة على إرادة المقيّد، فإذن لا نحتاج في استفادة الإطلاق إلى المقدّمة الثانية.
كما أنّه يمكن أن يقال: برجوع المقدّمة الثالثة إلى المقدّمة الاُولى؛ فإنّ المخاطب بالنظر الابتدائي وإن يحكم من جهة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر بكون الأقلّ تمام مراده، ولكن بالنظر الثانوي يكون هذا راجعاً إلى المقدّمة الاُولى وهو كونه في مقام
ص: 440
بيان المراد لا الإهمال والإجمال؛ لأنّه لو لم يكن القدر المتيقّن تمام مراده ولم يبيّن لما كان في مقام البيان. وكيف كان، هذا كلّه بناءً على ما اختاره المحقّق الخراساني(رحمه الله).
وأمّا بناءً على ما اخترناه من أنّ ملاك الإطلاق كون معنىً من المعاني تمام متعلّق الحكم من دون دخل خصوصية زائدة فيه، وأنّ الشياع والسريان ذاتيّ الماهيّات والمعاني الكلّية، فلا احتياج للتمسّك بالإطلاق إلّا إثبات كون المتکلّم في مقام بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه، فلا نحتاج إلى المقدّمة الثانية، ولا إلى الثالثة أيضاً؛ لعدم تصوّر قدر متيقّن في البين بعد فرض كون المتکلّم في مقام بيان تمام متعلّق حكمه الّذي هي الحيثية والطبيعة الكذائيه لا أفرادها ووجوداتها.
ثم إنّه لا يخفى عليك: أنّه بناءً على ما سلكه المشهور((1)) من لزوم أخذ الشياع والسريان في المطلق وعدمه في المقيّد يلزم أخذ خصوصية زائدة في معنى لفظ المطلق، وكذا في لفظ المقيّد لو قلنا بلزوم ملاحظة شياع المعنى في بعض أفراده في المقيّد ولا نقول بأنّه لم يؤخذ في معناه ذلك. وعلى هذا، لا يمكن استفادة الإطلاق - ولو فرض وجود المقدّمة الاُولى - إلّا من دالّ آخر، فإنّ لفظ المطلق لا يكفي لإفادة المعنى ولحاظ الشياع والسريان فيه أو تقيّده بقيد خاصّ، فلابدّ للمتكلّم أن يتوصّل لإفهام مقصوده من دالّ آخر، وإلّا فلفظ «أعتق رقبة» لا يفيد ذلك.
وهذا بخلاف ما اخترناه، فإنّه على مبنائنا لا تؤخذ الخصوصية الزائدة إلّا في جانب المقيّد، ولذا لو لم يأت المولى إلّا باللفظ المطلق وكان في مقام البيان يستفاد منه الإطلاق، فتدبّر.
ثم إنّه بعدما ظهر عدم الحاجة إلى المقدّمة الثانية والثالثة لاستفادة الإطلاق من الكلام، وأنّ تمام الملاك في استفادة الإطلاق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان، فلا
ص: 441
ريب في أنّ إحراز هذا ليس موكولاً بالسؤال عن المتکلّم، بل الظاهر من أمر الحكيم عبده بحيثية وعدم إتيانه بلفظ آخر في كلامه - غير هذا اللفظ الدالّ على هذه الحيثية - أنّه في مقام بيان تمام موضوعه لا ما هو جزء موضوعه. وهذا ممّا استقرّت عليه طريقة العقلاء، ولذا يحتجّون به. ويكون نظير أصالة الحقيقة وبناؤهم على عدم كون اللفظ الّذي تکلّم به المتکلّم عبرة لمعنى مجازي.
لا أقول: إنّ التمسّك بالإطلاق في المقام يكون أيضاً من باب أصالة الحقيقة، بل أقول: إنّ ملاك حمل الكلام على المعنى الحقيقي، وحمل فعل المتکلّم إذا أمر عبده بحيثية - على أنّ ما هو تمام موضوع حكمه ليس إلّا هذه الحيثية - ولم يأت المتکلّم بما یدلّ على دخالة غير هذه الحيثية في موضوعيّتها للحكم، من باب واحد. ألا ترى أنّه إذا صدر من المولى أمر متعلّق بحيثية مثل «عتق رقبة»، وورد أمر آخر منه متعلّق بهذه الحيثية مع قيد زائد مثل «عتق رقبة مؤمنة» وعلم من الخارج اتّحاد التكليف، مثل قوله: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و«إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» يقع التعارض بينهما من جهة ظهور كلّ منهما في أنّ ما هو تمام الموضوع ليس إلّا الحيثية المذكورة في كلام المولى، ولكن يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد، من جهة أنّ ظهور قوله «إن ظاهرت فاعتق رقبة» على كون تمام موضوع الحكم عتق الرقبة إنّما يكون لأجل عدم ذكر ما یدلّ على دخل خصوصية زائدة في موضوع حكمه، وأمّا بعد ذكره ولو في كلام منفصل، لا يبقى مجال للتمسّك بهذا الظهور، ولا يتمّ احتجاج العبد على المولى بسبب هذا الإطلاق، كما هو دأب العقلاء واستمرّت عليه سيرتهم.
وينبغي التنبيه على اُمور:
التنبيه الأوّل: بعدما عرفت من أنّ ملاك الإطلاق أن يأخذ الحاكم ماهيّة من
ص: 442
الماهيّات على نحو الإرسال دون التقييد في موضوع حكمه، بحيث كان تمام متعلّق حكمه هذه الماهية المرسلة الّتي لا قيد لها، يظهر لك عدم وجود فرق - في مقام ملاحظة الموضوع والطبيعة الّتي تكون مركّباً للحكم - بين كون الحكم أمراً أو نهياً.
ففي جانب الأمر يكون متعلّق الحكم وتمام موضوعه الطبيعة المذكورة في كلام المولى، وحيث إنّ معنى الأمر - كما حقّقناه سابقاً((1)) - هو البعث إلى الوجود والتحريك نحو إصدار الفعل، فبأوّل وجود منها يجب أن يسقط الأمر ويجزي ما أتى به، فلا مجال لبقاء الأمر على حاله بعد الموافقة، لاستحالة طلب الحاصل.
وفي جانب النهي حيث إنّه عبارة عن الزجر عن الوجود، فلا محالة إذا عصى المكلّف وأتى بفرد من أفراده يتحقّق العصيان، ولكن هذا لا يصير سبباً لسقوط النهي، فهو على حاله يكون باقياً؛ لأنّ التكليف لا يسقط بالعصيان وإن اشتهر بينهم سقوطه بالعصيان.((2))
ووجهه: عدم كون عصيان المكلّف سبباً لسقوط التكليف. ولو سقط في ظرف العصيان فسقوطه مستند إلى عدم إمكان بقاء الحكم. ففي جانب النهي لا مانع من بقاء التكليف في فرض العصيان (وقد مرّت الإشارة إلى هذا مفصلاً في المباحث الراجعة إلى النواهي).((3))
فما عن بعض أعاظم المعاصرين من أنّ المطلوب في جانب الأمر هو الطبيعة، لكن تكون ملاحظة الشياع والسريان في أفراده على سبيل البدلية، وفي جانب النهي على سبيل الاستغراق.
ليس في محلّه؛ فإنّ الشياع والسريان مضافاً إلى كونه غير دخيل في المطلب يكون
ص: 443
لازم إرسال الطبيعة وإطلاقها وعدم تقيّدها، ولازم ذلك شياع الحكم وسريانه إلى جميع الأفراد.
التنبيه الثاني: لا ريب في أنّه يجب أن لا يكون موضوع بعض الأحكام، كالأمر والنهي، مع قطع النظر عن الحكم موجوداً حتى يمكن البعث إليه والزجر عنه. ولكن ربما تكون أحكاماً متعلّقةً بموضوعاتها إذا كان موجودة أو مفروضة الوجود. وبعبارة اُخرى: يكون الحكم راجعاً إلى الماهية الّتي جعلت مرآةً لأفراده لا بخصوصياتها الفردية بل بمقدار يمكن أن يرى من مرآة الماهية، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْ-عَصْرِ * إِنّ الْإنْسَ-انَ لَفِي خُسْرٍ﴾؛((1)) وقول أمير المؤمنين(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «أَعْجبوا لهذا الإنسان ينظر بشَحم، ويتكلّم بِلَحم... إلخ».((2)) فلا فرق في سريان الحكم إلى جميع الأفراد بين هذا القسم والقسم الأوّل؛ لأنّ منشأه في کلّ منهما كون الماهية المرسلة غير المقيّدة بقيد تمام موضوع الحكم، والشياع والسريان لازم ذلك.
والحاصل: أنّ منشأ الإطلاق في کلّ منهما ليس إلّا إطلاق الموضوع وكون نسبة جميع أفراده إلى الحكم سواء.
ولكنّ الحقّ: أنّ القسم الثاني أشبه بالعامّ، لما قد ذكرنا في مباحث العامّ من أنّ کلّ مفهوم يشار بسببه إلى أفراد ماهية مخصوصة هو العامّ. ولابدّ في هذا القسم من أن يكون المتعلّق معرَّفاً بالألف واللام، كالبيع والإنسان وغيرهما. ومن جهة كون هذا القسم أشبه بالعامّ ذكروا في مبحث العامّ بأنّ المعرَّف باللام يفيد العموم؛((3)) ولذا
ص: 444
جعلوا مبحث الإطلاق والتقييد مخصوصاً بغير هذا القسم، كما يستفاد من تعريفهم بأنّ المطلق ما دلّ على شائع في جنسه.
وإذا ورد عليه تقييد وشكّ في بقاء الإطلاق بالنسبة إلى الباقي يتمسّك بأصالة العموم مثل العامّ ويثبت الحكم في الباقي.
وأمّا القسم الأوّل فبابه غير باب العموم، وسيأتي الكلام فيه في التنبيه الثالث إن شاء الله تعالى.
التنبيه الثالث: هل الاحتياج إلى قاعدة الحكمة لإثبات الإطلاق في جميع الموارد على السواء بحيث لابدّ في جميع الموارد من إحراز كون المتکلّم في مقام البيان أو لا؟
يمكن أن يقال: إذا كانت الحيثية المأخوذة في لسان الدليل تمام متعلّق الحكم ممّا يصحّ كونه في مقام الواقع تمام متعلّق الحكم ومطلوب المتکلّم أو جزء موضوع حكمه ومتعلّق طلبه، بحيث كان التمسّك بأصالة الحقيقة في الهيئات وموادّ الكلام في كلتي الصورتين على حالها، ولا ينافي كون المذكور في الكلام تمام الموضوع أو جزؤه مع إجراء أصالة الحقيقة، فلا مجال لإثبات الإطلاق إلّا بالتمسّك بقاعدة الحكمة وهذا مثل قوله: «أعتق رقبة»، فإنّ أصالة الحقيقة الجارية في موادّ هذا الكلام وهيئاته لا تنافي مع عدم كون عتق الرقبة تمام موضوع الحكم وبيان دخالة قيد فيه مثل الإيمان بدليل منفصل.
وأمّا إذا لم يكن كذلك بل لا يصحّ أن يكون المذكور في لسان الدليل بعض متعلّق الحكم ثبوتاً لمنافاته مع أصالة الحقيقة، فيمكن القول بعدم الاحتياج في إثبات الإطلاق إلى قاعدة الحكمة مثل أن يقال: «لا رجل في الدار» فإنّ مقتضى إجراء أصالة الحقيقة في لفظ «لا» الداخل على الطبيعة نفيها وكونها تمام الموضوع لهذا الحكم، فلو قلنا بإرادة نفي الرجل العالم منه لكان منافياً معه.
ولعلّ أن يكون باب النواهي أيضاً من هذا الباب؛ فإنّ لازم تعلّق النهي - الّذي هو
ص: 445
عبارة عن الزجر عن الوجود - بالطبيعة وأصالة الحقيقة الجارية في طرف النهي الداخل على الطبيعة عدم كون مراد المتکلّم معنى غير الزجر عن الطبيعة، فلو كان مراده غير هذا لكان مجازاً وليس من باب الاستعمال في المعنى الحقيقي.
والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
ص: 446
1. القرآن الکریم.
2. الإبهاج في شرح المنهاج، السبکي، عليّ بن عبد الکافي (م. 756ق.).
3. إتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین، الزبیدي، السّید محمد مرتضی، (م. 1205ق.)، بیروت، دار الفکر.
4. إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، النملة، عبد الکریم بن علی (م. قرن 14).
5. أجود التقریرات، النائیني، محمد حسین (م. 1355ق.)، المقرّر السیّد أبو القاسم الخوئي، قم، مطبعة العرفان، 1352ش.
6. الاحتجاج، الطبرسي، أحمد بن عليّ (م. 560ق.)، النجف الأشرف، دار النعمان، 1386ق.
7. الاحکام في اُصول الأحکام، الآمدي، عليّ بن محمد (م. 631ق.)، الریاض، المکتب الإسلامي، 1387ق.
8. إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین، الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله السیوري (م. 826ق.).
9. الاستبصار، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، دار الکتب الإسلامیة، 1390ق.
10. إشارات الاُصول، الکلباسي، محمد إبراهیم بن محمد حسن (م.1262ق.)، طهران، الطبعة الحجریة، 1245ق.
ص: 447
11. الأعلام، الزرکلي، خیر الدین (م. 1410ق.)، بیروت، دار العلم للملایین، 1980م.
12. الأمالي، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، قم، دار الثقافة، 1412ق.
13. الأمالی، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، قم، مؤسّسة البعثة، 1417ق.
14. أمان الأمّة من الضلال والاختلاف، الصافي الگلپایگاني، لطف الله، قم، المطبعة العلمیة، 1397ق.
15. انوار الملکوت في شرح الیاقوت، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، قم، منشورات الشریف الرضي، 1363ش.
16. أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، المفید، محمد بن محمد (م.493ق.).
17. إیضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، الحلّي، محمد بن حسن (م. 771ق.)، قم، المطبعة العلمیة، 1387ق.
18. الباب الحادي عشر، العلّامه الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، قم، منشورات المصطفوي، 1399ق.
19. بحار الانوار، المجلسي، محمد باقر (م. 1111ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، 1403ق.
20. بدائع الأفکار في الاُصول، العراقي، ضیاء الدین (م. 1381ق)، المقرّر میرزا هاشم الآملي، النجف الأشرف، المطبعة العلمیة، 1370ق.
21. بدائع الأفکار، الرشتي، میرزا حبیب الله بن محمد علي (م. 1312ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث.
22. بصائر الدرجات الکبری، الصفّار، محمد بن حسن (م. 290ق.)، طهران، مؤسّسة الأعلمي، 1404ق.
ص: 448
23. البصائر النصیریة في المنطق، ابن سهلان الساوي، عمر بن سهلان (م.450ق.)، قم، المدرسة الرضویة.
24. تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي، أحمد بن عليّ (م. 463ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1417ق.
25. التبیان فی تفسیر القرآن، الطوسي، محمد بن حسن (م. 460ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
26. تشریح الاُصول، النهاوندي، مولی عليّ بن مولی فتح الله، طهران، دار الخلافة، 1320ق.
27. التعریفات، الجرجاني، علیّ بن محمد (م. 816ق.)، طهران، منشورات ناصر خسرو، 1412ق.
28. تفسیر العیاشي، العیاشي، محمد بن مسعود (م. 320ق.)، طهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة.
29. التفسیر الکبیر، الفخر الرازي، محمد بن عمر (م. 606ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1420ق.
30. تقریرات آیة المجدد الشیرازي، الروزدري، علي (م. 1290ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409ق.
31. تهذیب الأحکام، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، طهران،دار الکتب الإسلامیة، 1364ش.
32. تهذیب الوصول إلی علم الاُصول، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.).
33. التوحید، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، قم، مؤسّسة النشر اسلامي، 1398ق.
ص: 449
34. تیسیر التحریر، امیر بادشاه، محمد أمین بن محمود (م. قرن 10).
35. جامع أحادیث الشیعة، البروجردي، السیّد حسین (م. 1380ق.)، قم، المطبعة العلمیة، 1399ق.
36. جامع الأخبار، الشعیری، محمد بن محمد (م. قرن 6)، النجف الأشرف، المطبعة الحیدریة.
37. جامع المقاصد فی شرح القواعد، الکرکي، عليّ بن حسین (م. 940ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1408ق.
38. جواهر الاُصول، المرتضوي النگرودي، محمد حسن، طهران، مؤسّسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني(قدس سره)، 1376ش.
39. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، النجفي، محمد حسن (م. 1266ق.)، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1366ش.
40. الجوهر النضید في شرح کتاب التجرید، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م.726ق.)، قم، منشورات بیدار، 1413ق.
41. حاشیة الصبّان علی شرح الاُشموني، الصبّان، محمد بن عليّ (م. 1206ق.)، قم، منشورات الزاهدي، 1412ق.
42. الحاشیة علی قوانین الاُصول، الموسوي القزویني، السیّد عليّ (م.1297ق.)، مطبعة حاجي إبراهیم التبریزي.
43. الحاشیة علی کفایة الاُصول، الحجّتي البروجردي، بهاء الدین، تقریرات أبحاث السیّد حسین البروجردي، قم، منشورات إسماعیلیان، 1412ق.
44. الحجّة في الفقه، الحائري الیزدي، مهدي، تقریرات درس السیّد حسین الطباطبائي البروجردي، أصفهان، مؤسّسة الرسالة، 1419ق.
ص: 450
45. الحدائق الناظرة، البحراني، یوسف بن أحمد (م. 1186ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي.
46. الخصال، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1403ق.
47. درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد، الخراساني، محمد کاظم (م. 1329ق.)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الاسلامي، 1410ق.
48. درر الفوائد، الحائري الیزدي، عبد الکریم (م. 1355ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1408ق.
49. دعائم الإسلام، المغربي، قاضي نعمان بن محمد التمیمي (م. 363ق.)، القاهرة، دار المعارف، 1383ق.
50. الذریعة إلی اُصول الشریعة، السیّد المرتضی، عليّ بن الحسین (م. 436ق.).
51. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، السبکي، عبد الوهاب بن عليّ (م. 771ق.).
52. روضة الناظر وجنّة المناظر، المقدسي، أحمد بن قدامة، مصر،المطبعة السلفیة، 1341ق.
53. زبدة الاُصول، البهائي العاملي، محمد بن الحسین (م. 1031ق.)، طهران، الطبعة الحجریة، 1319ق.
54. السرائر، ابن إدریس الحلّي، محمد بن منصور (م. 598ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1410ق.
55. سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، سلیمان بن الأشعث (م. 275ق.)، دار إحیاء السنة النبویة.
ص: 451
56. شرح الإشارات والتنبیهات، الخواجة نصیر الدین الطوسي، محمد بن محمد (م. 672ق.)، قم، نشر البلاغة، 1383ش.
57. شرح الاُصول الخمسة، القاضي عبد الجبار الأسد آبادي، عبد الجبار بن أحمد (م. 415ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1422ق.
58. شرح البدخشي والأسنوي علی مناهج العقول، البدخشي، محمد بن حسن (م. قرن7).
59. شرح التصریح علی التوضیح، الأزهري، خالد بن عبد الله (م. 905ق.)، مصر، دار إحیاء الکتب العربیة.
60. شرح الرضي علی الکافیة، رضي الدین الأسترآبادي، محمد بن الحسن (م. 688ق.)، طهران، مؤسّسة الصادق، 1395ق.
61. شرح السیوطي علی ألفیة ابن مالك ، السیوطي، جلال الدین (م. 911ق.).
62. شرح الشمسیة، قطب الدین الرازي، محمد بن محمد (م. 776ق.)،إیران، الطبعة الحجریة، 1304ق.
63. شرح العضدي علي مختصر ابن الحاجب، العضدي، عبد الرحمن بن أحمد، إسلامبول، مطبعة العالم، 1310ق.
64. شرح اللمع في اُصول الفقه، الشیرازي، إبراهیم بن عليّ (م. 474ق.).
65. شرح المطالع في المنطق، قطب الدین الرازي، محمد بن محمد (م. 776ق.)، قم، مکتبة المرعشي النجفي.
66. شرح المقاصد، التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر (م. 793ق.)، قم، منشورات الشریف الرضي، 1370ق.
ص: 452
67. شرح المنظومة، السبزواري، هادي بن مهدي (م. 1289ق)، قم، مکتبة العلّامة، 1369ش.
68. شرح المواقف، الجرجاني، عليّ بن محمد (م. 816ق.)، قم، منشورات الشریف الرضي، 1412ق.
69. شرح تجرید الاعتقاد، القوشجي، علّي بن محمد (م. 879ق.)، الطبعة الحجریة، 1285ق.
70. شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول، القرافي، أحمد بن إدریس (م. 684ق.).
71. الشفاء (المنطق)، ابن سینا، حسین بن عبد الله (م. 428ق.)، قم، مکتبة المرعشي النجفي، 1405ق.
72. شوارق الإلهام في شرح تجرید الکلام، اللاهیجي، عبد الرزاق بن علي (م. 1072ق.)، أصفهان، نشر المهدوي، الطبعة الحجریة.
73. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الجوهری، إسماعیل بن حمّاد (م. 393ق.)، بیروت، دار العلم للملایین، 1407ق.
74. ضوابط الاُصول، القزویني الحائري، السیّد إبراهیم بن محمد، الطبعة الحجریة.
75. طبقات أعلام الشیعة، آغا بزرگ الطهراني، محمد محسن (م. 1389ق.).
76. العدّة في اُصول الفقه، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، قم، مطبعة ستارة، 1417ق.
77. عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة، ابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن علي (م. 880ق.)، قم، مطبعة سیّد الشهداء، 1403ق.
78. عیون أخبار الرضا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، بیروت، مؤسّسة الأعلميّ، 1404ق.
ص: 453
79. فرائد الاُصول، الأنصاري، مرتضی (م. 1281ق.)، تبریز، الطبعة الحجریة، 1314ق.
80. الفصول الغرویة في الاُصول الفقهیة، الأصفهاني، محمد حسین بن عبد الرحیم (م. 1254ق.)، قم، دار إحیاء العلوم الإسلامیة، 1404ق.
81. فوائد الاُصول، الخراساني، محمد کاظم (م. 1329ق.)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1407ق.
82. فوائد الاُصول، النائیني، محمد حسین (م. 1355ق.)، المقرّر محمد عليّ الکاظمي الخراساني، قم، مؤسّسة النشر الإسلامی، 1376ش.
83. فواتح الرحموت، الأنصاري، محمد بن نظام الدین، قم، دار الذخائر،1368ش.
84. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال والحرام، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، قم، مؤسّسة النشر الاسلامي، 1413ق.
85. قوامع الفضول في الاُصول، العراقي، محمود بن جعفر (م. 1308ق.).
86. قوانین الاُصول، القمي، المیرزا أبو القاسم بن الحسن (م. 1231ق.)، طهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة، 1378ق.
87. الکافي، الکلیني، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363ش.
88. کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1407ق.
89. کفایة الاُصول، الخراساني، محمد کاظم (م. 1329ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث.
90. لمحات الاُصول، الإمام الخمیني، السیّد روح الله الموسوي (م. 1409ق.).
91. اللمع في الردّ علی أهل الزیغ والبدع، الأشعري، عليّ بن إسماعیل (م.330ق.).
ص: 454
92. مبادئ الوصول إلی علم الاُصول، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، قم، المطبعة العلمیة، 1404ق.
93. مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، أردبیلي، أحمد بن محمد (م. 993ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي.
94. المحاسن، البرقی، احمد بن محمد (م. 274ق.)، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1370ش.
95. المحصول فی علم اُصول الفقه، الفخر رازي، محمد بن عمر (م. 606ق.)، بیروت، مؤسّسة الرسالة، 1412ق.
96. مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، الشهید الثاني، زین الدین بن عليّ العاملي (م. 965ق.)، قم، مؤسّسة المعارف الاسلامیة، 1413ق.
97. مستدرﻙ الوسائل، المحدّث النوري، میرزا حسین (م. 1320ق.)، بیروت، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1408ق.
98. المستصفی في علم الاُصول، الغزالي، محمد بن محمد (م.550ق.)، قم، دار الذخائر، 1368ش.
99. مستطرفات السرائر، ابن ادریس الحلّي، محمد بن منصور (م. 598ق.).
100. المسلك في اُصول الدین، المحقّق الحلّي، جعفر بن حسن (م. 676ق.)، مشهد، آستان قدس رضوي، 1421ق.
101. مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل (م. 241ق.)، مصر، المطبعة المیمنیة، 1313ق.
102. مشارق الشموس في شرح الدروس، الخوانساري، حسین بن محمد (م. 1099ق.).
ص: 455
103. مطارح الأنظار، الکلانتري الطهراني، أبو القاسم بن محمد (م. 1292ق.)، تقریرات شیخ مرتضی الأنصاري، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1404ق.
104. المطالب العالیة، الفخر الرازي، محمد بن عمر (م. 606ق.).
105. المطوّل، التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر (م. 793ق.)، قم، مکتبة المرعشي النجفي، 1407ق.
106. معارج الاُصول، المحقّق الحلّي، جعفر بن حسن (م. 676ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام)، 1403ق.
107. معالم الدین وملاذ المجتهدین، العاملي، حسن بن زین الدین (م. 1011ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي.
108. المعتبر فی شرح المختصر، المحقّق الحلّي، جعفر بن حسن (م. 676ق.)، قم، مؤسّسة سیّد الشهداء(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، 1364ش.
109. المعتمد في اُصول الفقه، البصريّ، محمد بن عليّ (م.436ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1403ق.
110. المغني، القاضي عبد الجبّار الأسد آبادي، عبد الجبّار بن أحمد (م. 415ق.)، القاهرة، الدار المصریة، 1965م.
111. مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب، ابن هشام الأنصاري، عبد الله بن یوسف (م. 761ق.)، طهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة، 1291ق.
112. مفاتیح الاُصول، الطباطبائی، السّید محمد المجاهد (م. 1242ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام)، 1296ق.
ص: 456
113. مفتاح العلوم، السکّاکي، یوسف بن أبي بکر (م. 626ق.).
114. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، العاملي، السیّد محمد جواد (م. 1226ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1423ق.
115. مقالات الإسلامیین واختلاف المصلّین، الأشعري، عليّ بن إسماعیل (م.330ق.).
116. مقالات الاُصول، العراقي، ضیاء الدین (م. 1321ق.)، قم، مکتبة المرعشي النجفي.
117. المقنع، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، قم، مؤسّسة الإمام الهادي(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، 1415ق.
118. ملاحظات الفرید علی فوائد الوحید، الفرید الگلپایگاني، حسن (م. 1366ق.).
119. من لا یحضره الفقیه، الصدوق، محمد بن علي (م. 381ق.)، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1404ق.
120. مناهج الأحکام والاُصول، النراقي، أحمد بن محمد مهدي (م.1245ق.)، الطبعة الحجریة.
121. المنخول من تعلیقات الاُصول، الغزالي، محمد بن محمد (م. 505ق.).
122. الموافقات في اُصول الشریعة، الشاطبي، إبراهیم بن موسی (م.790ق.)، بیروت، دار المعرفة.
123. نقد المحصّل (تلخیص المحصّل)، الخواجة نصیر الدین الطوسي، محمد بن محمد (م. 672ق.).
ص: 457
124. نهایة الأفکار، العراقي، ضیاء الدین (م. 1361ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1405ق.
125. نهایة الدرایة في شرح الکفایة، الأصفهاني، محمد حسین بن عبد الرحیم (م. 1254ق.)، بیروت، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1429ق.
126. نهایة المرام في علم الکلام، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، قم، مؤسّسة الامام الصادق(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، 1419ق.
127. نهایة الوصول إلی علم الاُصول، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.).
128. نهج البلاغة، الإمام عليّ بن أبي طالب(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، الشریف الرضي، تحقیق وشرح محمد عبده، بیروت، دار المعرفة، 1412ق.
129. نهج الحقّ وکشف الصدق، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م.726ق)، قم، دار الهجرة، 1414ق.
130. هدایة المسترشدین في شرح معالم الدین، الأصفهاني، محمد تقي بن عبد الرحیم (م. 1248ق.)، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث.
131. همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربیة، السیوطي، جلال الدین (م. 911ق.).
132. الوافي، الفیض الکاشاني، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، الأصفهان، مکتبة الإمام أمیر المؤمنین عليّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) العامّة، 1406ق.
133. الوافیة في اُصول الفقه، الفاضل التوني، عبد الله بن محمد (م. 1071ق.)، قم، مؤسّسة إسماعیلیان، 1412ق.
134. وسائل الشیعة، الحر العاملي، محمد بن الحسن (م. 1104ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1414ق.
ص: 458
135. وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلکان، أحمد بن محمد (م.681ق.)، بیروت، دار الثقافة.
136. وقایة الأذهان، الأصفهاني، محمد رضا بن محمد حسین، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1413ق.
ص: 459
ص: 460
المقدّمة: في بيان اُمور. 7
الأمر الأوّل: في موضوع العلم 9
الأمر الثاني: في الوضع. 21
الأمر الثالث: في الاستعمال المجازي. 33
الأمر الرابع: في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، أو صنفه، أو شخصه. 35
الأمر الخامس: في أنّ الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي هي. 37
الأمر السادس: في علائم الحقيقة والمجاز. 39
الأمر السابع: في الصحيح والأعمّ 43
التنبيه الأوّل: المراد من الصحّة والفساد 43
التنبيه الثاني: تصوير الجامع. 44
التنبيه الثالث: ثمرة النزاع. 52
هنا مطالب.. 57
الأمر الثامن: في المشتقّ. 63
الأُولى: معنى المشتقّ المتنازع فيه. 63
الثانية: حيثية الصدق ومناط الحمل. 64
الثالثة: أقسام المشتقّات.. 64
ص: 461
الرابعة: المراد بالحال. 65
الخامسة: المراد بالأعمّ 66
محل النزاع في المشتقّ. 66
كيفية النزاع في المشتقّ. 67
تنبيهات.. 68
تذييل. 72
تأسيس الأصل. 73
بقي هنا اُمور. 76
الأمر الأوّل: بساطة المشتقّ. 76
الأمر الثاني: في الفرق بين المشتقّ ومبدئه. 78
الأمر الثالث: في الصفات الجارية على ذاته تعالى. 82
المقصد الأوّل: في الأوامر. 85
الفصل الأوّل: فيما يتعلّق بمادّة الأمر. 87
الجهة الاُولى والثانية: في معنى مادّة الأمر، واعتبار العلوّ والاستعلاء. 87
اعتبار العلوّ والاستعلاء. 88
الجهة الثالثة: في حقيقة الطلب.. 89
الجهة الرابعة: في تقسيم الطلب إلى الوجوبيّ والندبيّ. 102
فائدتان. 106
الجهة الخامسة: في التعبّدي والتوصّلي. 110
وجوه الإشكال في ناحية الأمر. 112
وجوه الإشكال في ناحية الإمتثال. 113
ص: 462
عدم الفرق بين داعي الأمر وغيره 116
الجواب عن الإشكالات.. 116
الحقّ في الجواب عن الإشكال. 121
الاستنتاج من المبحث.. 125
الفصل الثاني: فيما يتعلّق بصيغة الأمر. 127
المبحث الأوّل: في المرّة والتكرار. 127
تنبيه. 128
المبحث الثاني: في الفور والتراخي. 129
الأمر عقيب الحظر. 129
الفصل الثالث: في الإجزاء. 131
عنوان المسألة. 131
المراد من الاقتضاء والإجزاء. 132
الفرق بين الإجزاء، والمرّة والتكرار. 133
الفرق بين الإجزاء، وتبعية القضاء للأداء. 134
الموضع الأوّل: في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانياً 134
تبديل الامتثال. 135
الموضع الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري 135
حكم صورة الشكّ.. 139
تذنيب.. 140
الموضع الثالث: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي 141
تحرير محلّ النزاع. 143
ص: 463
المقام الأوّل: إجزاء الإتيان بمقتضى الاُصول الشرعية. 144
المقام الثاني: إجزاء الإتيان بمقتضى الأمارات الشرعية. 146
حكومة الأمارات على الاُصول. 147
إشكال التصويب.. 150
الفصل الرابع: في مقدّمة الواجب. 155
تحرير عنوان النزاع. 155
الأمر الأوّل: ليست المسألة اُصولية. 156
الأمر الثاني: أقسام المقدّمة. 157
حقيقة المعدّ، وعدم المانع، والسبب.. 163
المقدّمة السببیّة في الأفعال التوليدية. 164
الأمر بالمسبّب في الأفعال التوليدية. 165
التحقيق في حقيقة الشرط. 167
إشكال الشرط المتقدّم والمتأخّر. 168
الأمر الثالث: أقسام الواجب.. 170
رجوع الشرط إلى الهيئة أو المادّة 171
موارد رجوع الشرط إلى الهيئة أو المادّة 174
مقام الإثبات.. 175
تنبيهان. 177
غرض صاحب الفصول من التقسيم المذكور. 178
الشكّ في النفسية والغيرية. 183
استحقاق المثوبة والعقوبة. 185
ص: 464
الإشكال على عبادية الطهارات الثلاث.. 186
نكتة فقهية: في الوضوء التهيّئي. 189
الأمر الرابع: قصد التوصّل أو الموصليّة في وجوب المقدّمة. 189
الغرض من الأقوال الثلاثة. 193
ثمرة النزاع. 193
الأمر الخامس: تأسيس الأصل في المسألة. 193
تحرير محلّ النزاع. 194
الأقوال في المسألة. 195
نقد الأقوال بالتفصيل. 196
أدلّة وجوب المقدّمة ونقدها 198
تبرير لمختار الفصول. 200
مقدّمة المستحبّ والحرام 201
الفصل الخامس: في مسألة الضدّ 203
الأوّل: في معنى الضدّ 203
الثاني: كون المسألة من المبادئ الأحكامية. 204
الثالث: في مرادهم من الضدّ وكيفيّة الاقتضاء. 204
الضدّ العامّ 205
الضد الخاصّ.... 207
مقدّمية أحد الضدّين للآخر. 209
مقتضى التحقيق. 210
بيان آخر لمقدّمية الضدّ ونقده 210
ص: 465
الجواب عن النقد 211
ثمرة البحث.. 211
واستشكلوا في الجواب الأوّل. 213
تثبيت معنى التوسّع لتصوير الأمر بالضدّين. 214
الكلام في الترتّب.. 217
تذنيب.. 222
الفصل السادس: في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. 225
الفصل السابع: في الواجب التخييري. 227
أقسام الواجب التخييري.. 228
إمكان التخيير بين الأقلّ والأكثر. 229
الفصل الثامن: في الواجب الكفائي. 231
اختلاف التعاريف.. 231
نقد التعاريف.. 232
حقيقة الواجب الكفائي. 233
تنبيهان. 233
الفصل التاسع: في الواجب المطلق والموقّت. 235
دلالة الأمر بالموقّت على الأمر به خارج الوقت.. 236
الفصل العاشر: في متعلّق الأوامر والنواهي. 239
المقصد الثاني: في النواهي. 245
الفصل الأوّل: في مفاد الأمر والنهي. 247
التحقيق: اختلاف الأمر والنهي حقيقة وآثاراً 248
ص: 466
تنبيهان. 250
الخلاصة. 251
تعلّق النهي بالكفّ أو الترك؟. 252
تقسيم النهي إلى التعبّدي والتوصّلي. 253
تبصرة: في عدم سقوط التكليف بالعصيان. 254
الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهي. 255
تحرير محلّ النزاع. 255
مقدّمات البحث.. 258
دليل امتناع الاجتماع ونقده 261
دليل الامتناع في الكفاية ونقده 262
دليل جواز الاجتماع. 267
ثمرة النزاع. 268
تنبيهات.. 269
المختار في المسألة. 279
الفصل الثالث: في اقتضاء النهي للفساد 281
معنى الصحّة والفساد 282
تقسيم النهي في العبادات إلى الإرشادي والمولوي.. 285
أقسام النهي في المعاملات.. 285
الاستدلال على الفساد بفهم العلماء. 287
الاستدلال بالروايات.. 288
تذنيب.. 289
ص: 467
المقصد الثالث: في المفاهیم 291
الفصل الأوّل: في معنى المنطوق والمفهوم 293
شمول البحث على مفهوم المخالفة والموافقة. 296
ردّ إشكال على الشريف المرتضى(قدس سره). 297
الفصل الثاني: في المنشأ وما يحصل به المفهوم 299
مفاد المفهوم 301
الفصل الثالث: في مفهوم الشرط. 305
الفصل الرابع: في المفهوم في الجمل الإنشائية. 309
الفصل الخامس: هل المراد انتفاء سنخ الحكم أو شخصه؟ 311
الفصل السادس: في تعدّد الشرط ووحدة الجزاء. 313
الفصل السابع: في تداخل الأسباب والمسبّبات. 315
تحرير محلّ النزاع. 315
الاستدلال على عدم التداخل. 316
الفصل الثامن: في تطابق المفهوم مع المنطوق. 321
خاتمة: في سائر المفاهيم 322
المقصد الرابع: في العامّ 327
نکتة. 329
تعريف العامّ والخاصّ.... 329
الفصل الأوّل: في أقسام العامّ 331
تذنيب.. 332
الفصل الثاني: في وجود الصيغة للعموم 335
ص: 468
الفصل الثالث: فيما یدلّ على العموم 337
الفصل الرابع: في حجّية العامّ المخصَّص... 341
الفصل الخامس: في التمسّك بالعامّ عند إجمال المخصِّص مفهوماً 351
الفصل السادس: في التمسّك بالعامّ عند إجمال المخصِّص مصداقاً 353
دليل المجوّزين. 353
بيان آخر لتصحيح جواز التمسّك والجواب عنه. 358
وجهان آخران لعدم جواز التمسّك بالعامّ 360
التمسّك بالعامّ في المخصِّص اللبّي. 362
تنبيهات.. 365
التمسّك بالعامّ باستصحاب العدم الأزلي. 367
الفصل السابع: في التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص... 383
مقدار الفحص.... 389
الفصل الثامن: شمول الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين. 391
ثمرة النزاع. 398
الفصل التاسع: تعقب العامّ بضمير راجع إلى بعض أفراده 401
الفصل العاشر: تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف.. 405
الفصل الحادي عشر: الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة 409
الفصل الثاني عشر: جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 413
الفصل الثالث عشر: أحوال العامّ والخاصّ المتخالفين. 417
المقصد الخامس: في المطلق والمقيّد 419
الأمر الأوّل: في تعريف المطلق والمقيّد 421
ص: 469
الأمر الثاني: في ملاك الإطلاق والتقييد 425
الأمر الثالث: في ألفاظ المطلق. 429
الأمر الرابع: في اعتبارات الماهية وتقسيمها 435
الأمر الخامس: في إحراز الإطلاق إثباتاً 439
تنبيهات.. 442
مصادر التحقیق. 447
ص: 470
الصورة

ص: 471
الصورة

ص: 472
الصورة

ص: 473
الصورة

ص: 474
الصورة

ص: 475
الصورة

ص: 476
الصورة

ص: 477
الصورة

ص: 478
الصورة

ص: 479
الصورة

ص: 480
سرشناسه:صافی گلپایگانی، لطف الله ، 1298 -
Safi Gulpaygan, Lutfullah
عنوان و نام پديدآور:بیان الاصول/ تالیف لطف الله الصافی الگلپایگانی مدظله العالی.
مشخصات نشر:قم: مکتب تنظیم و نشر آثار آیت الله صافی گلپایگانی دام ظله ، 1439 ق. = 1396 -
مشخصات ظاهری:3 ج.
شابک: دوره 978-600-7854-60-0 : ؛ 630000 ریال : ج.1 978-600-7854-57-0 : ؛ 630000 ریال : ج.2 978-600-7854-58-7 : ؛ ج.3 978-600-7854-59-4 :
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
يادداشت:عربی.
يادداشت:چاپ دوم.
يادداشت:ج.2 - 3(چاپ دوم: 1439 ق. = 1396)(فیپا).
يادداشت:کتاب حاضر تقریرات درس آیت الله سیدحسین بروجردی است.
یادداشت:کتابنامه.
یادداشت:نمایه.
موضوع:اصول فقه شیعه
موضوع:* Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction
شناسه افزوده:بروجردی، سیدحسین، 1253 - 1340.
رده بندی کنگره: BP159/8 /ص26ب9 1396
رده بندی دیویی: 297/312
شماره کتابشناسی ملی:4942697
اطلاعات رکورد کتابشناسی:فیپا
ص: 1
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 2
ص: 3
بیان الاُصول
تألیف المرجع الديني الأعلى آية اللّه العظمى الشيخ لطف اللّه الصافي الگلپايگانيمدّظلّه العالی
الجزء الثاني
ص: 4
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد رسله وخير خلقه أبي القاسم محمد وآله الطيّبين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
وبعد، فهذا هو الجزء الثاني من محاضرات سيّد الأكارم وملاذ الأفاخم واُستاذ الأعاظم محيي رسوم الفقه بمباحثه القيّمة، ومشيّد أركان الاُصول بإفاضاته القويمة، حجّة الإسلام والمسلمين وآية الله العظمى في الأنام فريد عصره ووحيد دهره الحاج آغا حسين الطباطبائي البروجردي متّع الله المسلمين بطول بقائه، في اُصول الفقه، كتبته رجاء أن يجعله الله تعالى ذخراً لآخرتي يوم فقري وفاقتي ولحظات وحدتي ووحشتي، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكّلت وإليه اُنيب.
ص: 5
ص: 6
وفيه مقدّمة فيها اُمور:
الأمر الأوّل: المراد من «المكلّف» في تقسيم الشيخ
الأمر الثاني: مراتب الحكم
الأمر الثالث: تقسيم حالات المکلّف إلى القطع وغيره ومقامان:
المقام الأوّل: في القطع
المقام الثاني: في الظنّ
ص: 7
ص: 8
وقبل بيان ذلك نقدّم اُموراً:
قد اُورد على کلام الشيخ(قدس سره) وهو:
«إعلم: أنّ المکلّف إذا التفت إلى حكمٍ شرعيٍ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ... إلخ».((1))
بأنّ مراده من المکلّف إن كان المکلّف الشأني، فهو خلاف الظاهر. وإن كان المکلّف الفعلي، فيلزم منه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره.
ولا يمكن دفعه بالتعبير الّذي ذكره في الكفاية وهو: «إنّ البالغ الّذي وضع عليه القلم...».((2))
لأنّ مراده من «الّذي وضع عليه القلم» إن كان من وضع عليه القلم شأناً، فهو خلاف الظاهر أيضاً. وإن كان فعلاً، فيرد عليه ما ذكر.
والحقّ عدم ورود الإيراد المذكور على العبارة؛ لأنّ المراد بالمكلّف هو المکلّف الفعلي؛ ومن المعلوم أنّ کلّ بالغٍ عاقلٍ يكون مكلّفاً فعلياً باعتبار تعلّق التكاليف
ص: 9
الض_رورية به وفعليّتها في حقّه، ثمّ ينقسم باعتبار غيرها من الأحكام والتكاليف إلى الأقسام المذكورة، ولا يلزم كونه تقسيماً للشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا بيّن.
والظاهر أنّ مطلق الالتفات لا يكون موجباً للقطع أو الظنّ أو الشكّ؛ فإنّه ربما يلتفت الإنسان إلى الموضوع والحكم والنسبة، وليس له التفات إلى وقوع هذه النسبة حتى يطلب العلم به، فيحصل له علمٌ قطعيٌ أو ظنيٌ به أو يبقى مردّداً بينهما. وبعبارة اُخرى: لا يكون التفاته التفاتاً تصديقياً، فلا يفيد التفاته التصورّي إلّا تصوّر الموضوع والحكم والنسبة.
ص: 10
قد أفاد شيخنا العلّامةرحمه الله: أنّ للحكم مراتب أربع((1))وقسّمه باعتبارها إلى:
الشأني: وهو وجود شأنية الوجود له، واقتضاء وجوده من دون أن يكون بالفعل موجوداً؛ وذلك بأن تكون في الفعل مصلحةٌ مقتضيةٌ للبعث إليه، أو مفسدةٌ مقتضيةٌ للزجر عنه.
والإنشائي: وذلك بأن يكون للحكم وجودٌ إنشائيٌ من دون أن يكون له بعث وزجر وترخيص فعلاً؛ وذلك بأن يكون للمولى مثلاً سجلٌّ يسجّل فيها أحكامه الراجعة إلى عبيده ولكن لم يخاطبهم ولم يصل ما كتب فيه إلى مرتبة البعث والزجر.
والفعلي: وهو كونه متوجّهاً إلى العبد وباعثاً وزاجراً من دون أن يكون منجّزاً بحيث يعاقب عليه.
والمنجّز: وهو وجود ذلك له مع تنجّزه فعلاً.
وقد أفاد أخيراً بأنّ للحكم خمس مراتب:
أوّلها: مرتبة الاقتضاء.
ثانيها: مرتبة الإنشاء.
ص: 11
ثالثها: مرتبة البعث والزجر، ويعبّر عنه في هذه المرتبة بالحكم الفعلي ما قبل التنجّز.
رابعها: مرتبة الفعلية، وهي مرتبة علم المکلّف بالحكم، ويعبّر عنه في هذه المرتبة بالحكم الفعلي مع التنجّز.
خامسها: مرتبة التنجّز.
هذا، ولكن لنا أن نقول: إنّ الاختلاف في المرتبة إنّما يتصوّر في الحقائق المختلفة في الشدّة والضعف وغيرهما. وبعبارة اُخرى: فيما هو مقولٌ بالتشكيك، وتكون الحقيقة في جميع المراتب محفوظةً. وأمّا إذا لم تكن الحقيقة في جميع المراتب محفوظةً بل كان کلّ منها حقيقةً خاصّةً، لا يصحّ عدّها من مراتب شيءٍ واحدٍ.
فعلى هذا، وجود المصلحة في الفعل أو المفسدة، بحيث تكون له شأنية ترتّب الحكم عليه، ليس من مراتب الحكم والتكليف.
كما أنّ الإنشاء أيضاً ليس من مراتبه؛ فإنّ الحكم عبارة عن البعث والزجر وهما مفاد قولنا: «إفعل» و«لا تفعل»، ومن الواضح أنّ الحكم الإنشائي _ بمعنى تسجيله في السجلّ كما أفاده _ ليس من مراتب الحكم والتكليف، لعدم تحقّق حقيقة الحكم وهو البعث والزجر فيه.
وأمّا التنجّز، فهو أيضاً ليس من مراتب الحكم، بل يحصل من تقارن الحكم مع أمر خارج عن حقيقته، وهو وصوله إلى المکلّف.
والّذي ينبغي أن يقال: إنّ الحكم، أي الأمر والنهي، إنّما يقال على إنشائهما لانبعاث المکلّف نحو الفعل وإيجابه لبعثه وتحريكه إليه أو لزجره عنه. ولكن لا
يترتّب عليه انبعاث العبد أو انزجاره عن الفعل الّذي هو روح الحكم إلّا في صورة علم العبد به. فعلى هذا، تكون للحكم مرتبتان:
أوّلهما: مرتبة الإنشاء، وهي عبارة عن: إنشاء الحكم لينبعث العبد ويتحّرك نحو
ص: 12
الفعل، أو ينزجر عنه. وبعبارة اُخرى: هذه المرتبة عبارة عن: إنشاء ما يصلح لأن يكون داعياً للعبد أو زاجراً له بعد علمه به.
لا نقول: إنّ إنشاءه وبعثه وزجره متوجّهٌ إلى من يعلم به، بل إنّما ينشأ أمره ونهيه مطلقاً، وهو لا يصلح إلّا لانبعاث من علم به.
ثانيتهما: مرتبة الفعلية وترتّب الانبعاث عليه، وهي فيما إذا حصل العلم به للمكلّف وهو الحكم الإنشائي الفعلي.
لا يقال: لا حاجة لترتّب الانبعاث على الحكم إلى علم المکلّف به، بل يكفي في ذلك احتمال وجود الأمر.
فإنّه يقال: ليس الانبعاث على هذا أثراً للحكم ومترتّباً عليه، بل هو مترتّب على احتمال وجود الأمر، وهو حاصلٌ ولو لم يكن أمرٌ واقعاً، فلابدّ لوصول الحكم إلى مرتبة الفعلية من علم العبد به. وليس معناه أنّ الحكم مقيّدٌ بالعلم؛ لأنّه مستلزم للدور، بل المراد أنّ المولى لا يريد انبعاث العبد بالحكم الّذي أنشأه مطلقاً بل إذا كان عالماً به.
نعم، لا مانع من إيجاب المولى _ لحفظ المصلحة الكامنة في المأمور به، أو عدم وقوع العبد في مفسدة الفعل المنهيّ عنه استصلاحاً لحال العبد _ الاحتياط عليه فيما إذا احتمل وجود الأمر أو النهي حتى ينبعث نحو الفعل المأمور به أو ينزجر عن الفعل المنهيّ عنه، أو يعيّن له طريقاً وأمارةً على الحكم لينبعث نحوه، كأن يقول: إذا قام خبر الواحد أو الشهرة على وجوب فعلٍ أو حرمته إعمل به. وإذا كنت متيقّناً في حكمٍ ثم شككت فيه فابن على بقائه. ويعبّر عن هذه الأحكام بالأحكام الظاهرية الطريقية الّتي ليست لها مصلحة إلّا مصلحة حفظ الأحكام الواقعيّة، وليس لها استقلالٌ ونفسيةٌ كالأحكام الواقعية.
ص: 13
ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده الشيخرحمه الله _ ولعلّه المرضيّ عند المحقّق الخراساني في مبحث الظنّ _ من القول بأنّ حجّية الطرق والأمارات إمّا أن تكون من باب الطريقية أو من باب الموضوعية. ليس في محلّه؛ لأنّ مثل هذه الأحكام الّتي ليست لها نفسيّةٌ ومصلحةٌ إلّا بملاحظة الأحكام الواقعية لا يتصوّر فيها موضوعيةٌ ومصلحةٌ حتى يصحّ هذا التقسيم.
ص: 14
قد ظهر لك ممّا ذكر: أنّ ما هو المشهور من أنّ الحكم الظاهري هو الحكم الّذي يكون موضوعه الشكّ في الحكم الواقعي.
ليس في محلّه؛ لأنّه يلزم منه إمكان أن تكون للحكم الظاهري نفسية واستقلال، وأن لا تكون رعاية للحكم الواقعي، وهو خلاف التحقيق. مع أنّ جعل الحكم الظاهري لا يكاد يصحّ إلّا في مورد يكون الخطاب المتكفّل للحكم الواقعي قاصراً عن بعث المکلّف أو زجره، فلا يكون الشكّ موضوعاً للحكم الظاهري إلّا إذا كان لازماً لشأنية الحكم الواقعي وقصوره عن البعث والزجر من جهة عدم علم العبد به.
ففي الحقيقة: يكون موضوع الحكم الظاهري شأنية الحكم الواقعي وقصوره في إيجابه لانبعاث العبد، وهذا وإن كان ملازماً للشكّ في الحكم الواقعي لعدم قصور الخطاب إلّا في صورة الشكّ في الحكم الواقعي دون صورة العلم به _ كما مرّ _ ولكن موضوع الحكم الظاهري ليس إلّا شأنيّة الحكم الواقعي.
وبعبارة اُخرى: الشكّ في الحكم الواقعي لازمٌ أعمّ لشأنية الحكم وقصور الخطاب. فربما نشكّ في الحكم الواقعي وهو موجود شأناً، وربما نشكّ فيه من غير أن يكون حكم في البين أصلاً، وقصور الخطاب إنّما يكون في الصورة الاُولى، وهو الموضوع للحكم الظاهري لهذه الصورة دون الثانية.
ص: 15
وكيف كان إذا عرفت ذلك کلّه، فاعلم: أنّ الشيخ رحمه الله أفاد في أوّل الرسالة بأنّ المکلّف إذا التفت إلى حكمٍ شرعيٍ، فإمّا أن يحصل له القطع أو الشكّ أو الظنّ.((1)) وبيّن حكم القطع في المقصد الأوّل. وأشار إلى حكم الشكّ هنا، وذكره مفصّلاً في المقصد الثالث. ولم يتعرّض في هذا المقام لحكم الظنّ وذكره في المقصد الثاني مفصّلاً.
وقد أشكل المحقّق الخراساني قدس سره على تثليثه الأقسام بتداخل الظن والشك بحسب الحكم.
أمّا دخول الشكّ في الظنّ، كما إذا اعتبر مثلاً خبر من لم يتحرّز عن الكذب غالباً من جهة حكايته، فلا يبقى معه مجالٌ للرجوع إلى الأصل أصلاً.
وأمّا دخول الظنّ في الشكّ، كما في صورة حصول الظنّ الّذي لا يساعد على اعتباره دليلٌ، فيلحقه ما للشكّ من الرجوع في مورده إلى الاُصول.
ولهذا عدل عنه وقال في الكفاية: «إنّ البالغ الّذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكمٍ فعليّ واقعيٍّ أو ظاهريٍّ متعلّقٍ به أو بمقلّديه فإمّا أن يحصل له القطع به أو لا... إلخ».((2))
وعبر بالحكم الفعلي لإخراج ما ليس بفعليٍّ كالحكم الاقتضائي أو الإنشائي. وبالواقعيّ والظاهريّ لتقريب المسافة وتمهيداً لتثنية الأقسام.
ثم قال: «وإن أبيت إلّا عن ذلك، فالأولى أن يقال: إنّ المکلّف إمّا أن يحصل له القطع أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقوم عنده طريقٌ معتبرٌ أو لا».((3))
هذا، مضافاً إلى أنّ لازم ما أفاده الشيخ(قدس سره) كون التقسيم خماسياً، فإنّ في صورة
ص: 16
الظنّ إمّا أن يقوم عنده دليلٌ على اعتباره أو لا، فيرجع حكمه إلى حكم الشكّ، وفي صورة الشكّ إمّا أن يكون شكّه من الشكوك الّتي في مورده حكم للشارع أو لا؟
وقد أجاب بعضهم عن هذا الإشكال بأنّ تثليث الأقسام إنّما هو باعتبار الحالات النفسانية واختلافها من حيث المنجزّية؛ فإنّ القطع منجّزٌ صرفٌ، والشكّ غير منجّز صرفٍ، والظنّ لا منجّز ولا غير منجّز، أي: هو برزخٌ بينهما.
وفيه أوّلاً: أنّه يأتي فيما بعد إن شاء الله إمكان عدم كون القطع منجّزاً في بعض الموارد.
وثانياً: أنّ اتّصاف الظنّ باللامنجزية والمنجزية وكونه برزخاً في ذلك بين القطع والشكّ محلّ إنكارٍ؛ فإنّ الظنّ لو قام على اعتباره دليل يكون منجّزاً كالقطع، وإلّا فليس بمنجّزٍ ويكون حاله حال الشكّ.
أمّا الشكّ فهو أيضاً يمكن أن يكون منجّزاً كالقطع، كما في صورة احتمال أن يكون الغريق ابن المولى، فإنّ نفس هذا الاحتمال يكون منجّزاً أي موجباً لاستحقاق العقاب لو لم يعتنِ العبد به واتّفق كونه ابن المولى. ومثل احتمال صدق مدّعي النبوّة، فإنّ مجرّده منجّز وموجب لاستحقاق العقاب لتركه تصديق النبيّ لو اتّفق صدق مدّعيها. ومثل احتمال بقاء الحالة السابقة، فإنّه يكون منجّزاً لاستحقاق العقاب على ترك التكليف بحكم الشارع.
ولا نقول: إنّ الاحتمال كاشف عن الواقع، بل نقول: إنّ الشكّ في مثل هذه الموارد منجّز للواقع عقلاً أو شرعاً.
هذا، ولكن يمكن الإشكال على ما أفاده في الكفاية: بأنّ الحكم المتعلّق للقطع لابدّ وأن يكون صالحاً للتنجّز واستحقاق العقوبة على مخالفته؛ والحكم الظاهريّ ليس صالحاً له _ كما أفاد أخيراً في مجلس بحثه بأنّه ليس في موارد الطرق والأمارات حكمٌ وجوبيٌ متعلّقٌ بالعمل بها، بل ليس مفادها إلّا جعل الحجّية والمنجزّية. ولو كان
ص: 17
المجعول حكماً وجوبياً فهو طريقيٌ صرفٌ لا مجال لتنجّزه واستحقاق العقوبة على مخالفته بنفسه _ .
فلا يستقيم هذا التقسيم (الثنائي) بحسب الظاهر، لأنّه إنّما يكون باعتبار منجّزية القطع، مع أنّ الحكم الظاهريّ المقطوع به لا يتنجزّ بسبب القطع، وليس فيه صلاحية التنجّز واستحقاق العقاب على مخالفته بنفسه.
وأمّا بيانه الآخر وهو تثليث الأقسام، فلا إشكال فيه.
وإن شئت تثنية الأقسام فقل: إنّ المکلّف إذا التفت (بالمعنى الّذي ذكرنا للالتفات) إلى حكمٍ شرعيٍّ إنشائيٍّ، فإمّا أن يكون للحكم منجّزٌ في البين أو لا، وعلى الأوّل فسيأتي الكلام في كونه موجباً لاستحقاق العقاب على مخالفة التكليف، وأنّه لا معنى لتنجّز الحكم إلّا استحقاق العقاب على مخالفته، وعلى الثاني المرجع هو البراءة .
ويدخل _ على هذا البيان _ في المنجِّز: القطع والأمارات المعتبرة والاحتمال والاستصحاب، فإنّه حكمٌ ظاهريٌ منجّز للتكليف الّذي احتمله العبد في ظرف وجود الحالة السابقة.
ويدخل في القطع: الاشتغال والتخيير، لوجود العلم بالتكليف الّذي يكون منجّزاً له في موردهما.
ولتوضيح المقام نقول: إنّ المکلّف إمّا أن يتعلّق قطعه بحكمٍ تفصيلاً أو إجمالاً،
سواءٌ كان إجماله من جهة نوع التكليف مع العلم بأصله، كالعلم بأنّ هذا الفعل إمّا واجبٌ وإمّا حرامٌ، أم كان من جهة تردّده بين شيئين أو أشياء مع معلومية نوع التكليف. وعلى کلّ حالٍ فإمّا أن يمكن فيه الموافقة القطعية والمخالفة القطعية والموافقة الاحتمالية.
وإمّا أن لا يمكن الموافقة القطعية ويمكن الموافقة الاحتمالية والمخالفة القطعية.
وإمّا أن لا يمكن إلّا الموافقة الاحتمالية.
ص: 18
ففي الفرض الأوّل، _ أي فرض إمكان الموافقة القطعية والمخالفة القطعية _ يكون تعلّق العلم بالتكليف المردّد بينهما موجباً لتنجّزه واستحقاق العقوبة على مخالفته، فلو ترك المکلّف أحد المشتبهين واتّفق مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال لكونه في الطرف الّذي تركه فإنّه يستحقّ العقوبة على المخالفة ويكون كمن ترك کلّ واحد من المشتبهين.
واستحقاق العقوبة إنّما يكون على مخالفة هذا التكليف الّذي تعلّق به العلم لا غيره. فلو فرض كون کلّ واحدٍ من المشتبهين متعلّقاً للحكم رأساً ولكنّ القطع تعلّق بأحدهما إجمالاً ولم يأت المکلّف إلّا بأحد المشتبهين فاتّفق وقوعه في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال استحقّ العقوبة عليه، وإن أتى بالتكليف الّذي لم يتعلّق به علمه بإتيانه بالطرف الآخر، وكذا لو لم يأت في هذا الفرض بأحد منهما لم يعاقب إلّا على مخالفة تكليفٍ واحدٍ، وهو التكليف المعلوم بالإجمال دون المجهول .
فعلى هذا، تكون أصالة الاشتغال ووجوب الاحتياط _ فيما أمكنت فيه الموافقة القطعية والمخالفة القطعية _ منجّزة للتكليف من جهة تعلّق القطع بالحكم المردّد بينهما وسببيته لتنجّز الحكم. وبعبارة اُخرى: وجود المنجّز _ وهو العلم _ يكون سبباً لتنجّز التكليف المعلوم بالإجمال ، ولازمه وجوب الاحتياط.
وأمّا الفرض الثاني، وهو ما أمكنت فيه المخالفة القطعية والموافقة الاحتمالية دون القطعية، كما لو تردّد الوجوب بين صلاة الجمعة والظهر مع فرض عدم قدرته إلّا على الإتيان بإحداهما، فلو ترك کلّ واحدة منهما واتّفق مصادفة قطعه مع الواقع استحقّ العقوبة على المخالفة لتنجّز التكليف المعلوم بالإجمال بهذا النحو من التنجيز الّذي مقتضاه لزوم الإتيان بحكم العقل بإحداهما مع كونه مخيّراً في الإتيان بأيّهما شاء إذا كان احتماله في وجود التكليف المعلوم بالإجمال بالنسبة إلى کلا الطرفين على السواء. وأمّا إذا كان احتمال التكليف في أحد الطرفين أقوى وأرجح من الآخر فيدور الأمر بين
ص: 19
التعيين والتخيير والعقل يحكم بلزوم الإتيان بالطرف المظنون مصادفته للواقع، فيصير ظنّه هذا موجباً لتنجز الواقع لو كان في الطرف المظنون، فيستحق العقوبة على المخالفة لو أتى بالطرف المرجوح دون الراجح.
وأمّا الفرض الثالث _ وهو عدم إمكان الموافقة القطعية والمخالفة القطعية _ فلو كان احتمال مصادفة التكليف في أحد الطرفين أقوى من الآخر فالكلام هو ما ذكر في الفرض الثاني.
ولو كان احتمالها في کلّ واحدٍ منهما على السواء فالعقل يحكم بتخيير المکلّف بين ارتكاب الطرفين لكن لا بنحو الإلزام واللزوم كما كان في التخيير المذكور في الفرض الثاني لإمكان المخالفة القطعية فيه، فكان المکلّف ملزماً بحكم العقل باختيار أحدهما، وأمّا في هذا الفرض فلا مجال لإلزام العقل لدوران أمر المکلّف مدار الفعل والترك فلا يحكم العقل إلّا بعدم استحقاق العقاب عند
مخالفة التكليف، ففي الحقيقة حكم العقل إنّما هو البراءة عن العقاب وقبح التوبيخ والعتاب. ولهذا قلنا: إن لم يكن منجّز في البين يكون المرجع هو البراءة ولم نذكر التخيير.
وقد ظهر ممّا ذكرناه إشكالٌ آخر على عبارة الرسائل في قوله: «فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاكّ»،((1)) فإنّ هذه القواعد _ غير الاستصحاب الّذي هو حكمٌ ظاهريٌ منجّز شرعاً للحكم ال_شرعي _ ليست إلّا من القواعد العقلية؛ إذ الاشتغال والتخيير من أحكام العقل والبراءة أيضاً كذلك، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك کلّه، فاعلم: أنّ الكلام يقع في مقامين.
ص: 20
والكلام فيه يقع طيّ اُمورٍ:
قد ذكر في أوّل الكتاب عند البحث عن المراد من موضوع العلم _ الّذي يكون تمام الملاك لامتياز العلوم بعضها عن بعضٍ _ ، وعن موضوع علم الاُصول ما يظهر منه دخول البحث عن حجّية القطع ومنجّزيته في مباحث هذا العلم.
وقد بيّنا هناك أنّ موضوع علم الاُصول هو الحجّة في الفقه، فكلّ ما كان سبباً لاحتجاج المولى على عبده وحجّةً له عليه لو خالفه وعصاه، أو كان حجّة للعبد عند المولى فيما لو وقع في مخالفته، يكون البحث عنه داخلاً في هذا العلم ومن مسائله؛ لأنّ المراد من العوارض الذاتية الّتي يجب أن يبحث عنها في العلم ليس ما اصطلح عليه الطبيعيون وقسّموه إلى المقولات التسع وقابلوه بالجوهر، بل المراد منها _ كما صرّح به شارح المطالع((1)) وغيره، ويظهر من تتبّع مسائل العلوم _ ما اصطلح عليه المنطقيّون
ص: 21
وقسّموه إلى الخاصّة والعرض العامّ ، وقابلوه بالذاتي المنقسم إلى النوع والجنس والفصل، وهو الخارج المحمول، أي الكلي الخارج عن الش_يء مفهوماً المتّحد معه وجوداً. فعلى هذا، يكون القطع من المسائل الاُصولية؛ لأنّه حجّة للمولى على العبد لو خالفه. ويكون مغايراً للحجّة في الفقه مفهوماً ومتّحداً معها وجوداً، فنقول: القطع حجّة. وهكذا الكلام في الشهرة وخبر الواحد وغيرهما، كما تقول: الشهرة حجّة وخبر الواحد حجّة.
فلا وجه للقول بكون البحث عن القطع أشبه بالمسائل الكلامية؛((1)) لأنّه لو كانت من جهة أنّ النزاع واقعٌ في صحّة معاقبة القاطع وحسن عقابه في صورة المخالفة ليرجع البحث فيه عمّا يصحّ صدوره من الله تعالى وما يمتنع.
ففيه: أنّ المبحوث عنه في علم الكلام إنّما هو جواز صدور الفعل القبيح وعدمه من الله تعالى، فجوّزه الأشعري لإنكاره الحسن والقبح العقليين وأنّ الحَسَن ما صدر منه والقبيح ما لم يصدر منه، وأنكره العدلية، ولا يبحث في علم الكلام عن مصاديق ذلك وخصوصياته.
وإن كانت أشبهيته بالمسائل الكلامية من جهة رجوعه إلى أنّ العمل بالقطع هل يوجب الثواب؟ أو أنّ مخالفته هل توجب العقاب في الآخرة أو لا؟ ليرجع إلى المباحث المتعلّقة بالمعاد.
ففيه: أنّ المبحوث عنه في المعاد أيضاً ليس إلّا أصل المعاد والجزاء والثواب والعقاب، ولا يبحث فيه عن فعلية العذاب بالنسبة إلى المعاصي. ولا مجال للبحث عنه؛ لأنّ فعلية الجزاء ليست ممّا يمكن الاطّلاع عليها بخصوصيّاتها.
ص: 22
إن قلت: كيف يكون القطع من مسائل علم الاُصول مع عدم ذكره في كتب القدماء؟
قلت: عدم ذكره في كتب القدماء إنّما هو من جهة عدم انقداح شبهةٍ في منجّزية العلم عندهم، وإنّما ذكره المتأخّرون حيث أنكر بعض الأخباريين حجّيته إذا كان مأخوذاً من الأدلّة العقلية.
ثم إنّه قد ظهر ممّا ذكر أنّه لا تفاوت في إطلاق الحجّة على القطع وعلى سائر المنجّزات كالأمارات المعتبرة الشرعية؛ لأنّ إطلاق الحجّة على کلّ منهما إنّما هو من جهة كونه حجّة وسبباً لتنجّز الحكم الواقعي، ولا فرق في ذلك بين القطع وغيره.
فلا وجه لأن يقال بأنّ إطلاق الحجّة عليه ليس كإطلاق الحجّة على الأمارات المعتبرة شرعاً؛ لأنّ الحجّة عبارة عن الأوسط الّذي به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر كالتغيّر لإثبات حدوث العالم، فقولنا: «الظنّ حجّة» أو «البيّنة حجّة» أو «فتوى المفتي حجّة» يراد به كون هذه الاُمور وسائط لإثبات أحكام متعلّقاتها.((1))
لأنّه يقال: مضافاً إلى أنّ الحجّة في اصطلاح المنطقيّين عبارة عمّا هو المرکّب من القضيتين.
لو سلّمنا كونها عبارةً عن الوسط الّذي به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر اصطلاحاً خاصّاً للاُصوليّين لا تكاد تتمّ به حجّية الأمارات وصحّة إطلاقها عليها؛ لأنّ إطلاق الحجّة على خبر الواحد أو البيّنة وغيرهما ليس من جهة كونها وسائط لإثبات أحكام متعلقاتها، فإنّ المراد بقولنا: «خبر الواحد حجّة» أو «فتوى المفتي حجّة» ليس كونه حجّةً على الحكم الظاهري الّذي يستفاد من دليل حجّيته ويقع وسطاً للقياس في قولنا: «هذا ما أخبر العادل بوجوبه، وكلّ ما أخبر العادل بوجوبه واجبٌ فهذا واجب» أو «هذا مظنون الوجوب، وكلّ مظنون الوجوب واجبٌ فهذا
ص: 23
واجبٌ»، بل المراد كون خبر الواحد أو الظنّ أو غيرهما حجّة على الحكم الش_رعي الواقعي وسبباً لتنجّزه واستحقاق العقوبة على مخالفته لو صادف الواقع، وفي القياس المذكور جعل ما أخبر به العادل وسطاً لإثبات الحكم الظاهري وهو وجوب کلّ ما أخبر به العدل، فتدبّر.
لا ريب في حكم العقل بوجوب متابعة القطع، ومعناه: حكمه بتنجّز التكليف المقطوع به في صورة الإصابة واستحقاق العقوبة على المخالفة. ولا فرق في ذلك، أي حكم العقل بوجوب متابعته وتنجّز التكليف به، بين القاطع وغيره.
ولكن يظهر من الشيخ(قدس سره) أنّ وجوب متابعته عبارةٌ عن أنّ القاطع يرى وجوب الإتيان بما لو أتى به لكان إتيانه به متابعةً للقطع بالحمل الشائع الصناعي. وبعبارة اُخرى: لا يكون وجوب متابعته إلّا حكماً شرعياً بمعنى أنّ القاطع يرى وجوب الإتيان بمقطوع الوجوب، وحرمة الإتيان بمقطوع الحرمة. وقد علّل ذلك بأنّ القطع بنفسه طريقٌ إلى الواقع.((1))
وفيه: أنّ هذا غنيٌّ عن البيان، فإنّه لا مجال لإنكار أنّ القاطع بوجوب شيءٍ قاطعٌ بوجوب هذا الشيء، وأنّ من يرى وجوب شيءٍ شرعاً يرى وجوبه شرعاً.
وأمّا تعليله بأنّ القطع بنفسه طريقٌ إلى الواقع، فمن قبيل تعليل الشيء بنفسه؛ فإنّ معناه أنّ القاطع يرى وجوب ما قطع بوجوبه شرعاً لأنّه قاطعٌ به، ويرى وجوبه كذلك.
هذا، وإنّما لم نقل بكون القطع عذراً فيما أخطأ قصوراً؟ وإن أفاد في الكفاية كونه
ص: 24
هكذا؛((1)) لأنّ ما يوجب العذر للمكلّف في مقام احتجاج المولى عليه إنّما هو عدم انكشاف التكليف لا القطع بضدّه.
وأمّا أنّ تأثير القطع في تنجّز الحكم ليس بجعل جاعل لعدم جعلٍ تأليفيٍّ حقيقةً بين الشيء ونفسه، فلا يحتاج إلى بيان. ومع ذلك فالأحسن عدم التعبير عن هذا بما عبّر عنه في الكفاية بقوله: «لعدم جعلٍ تأليفيٍّ حقيقةً بين الش_يء ولوازمه بل عرضاً يتبع جعله بسيطاً»،((2)) فإنّه لو قال: بين ال_شيء ونفسه لكان أولى؛ إلّا أن يراد باللوازم اللوازم غير المتأخّرة عن الذات، وأمّا اللوازم المتأخّرة فلا مانع من تعلّق الجعل التأليفي بها، كما لا يخفى.
لا يخفى: أنّه لا دخل للقطع _ الّذي قلنا بأنّه منجّز للواقع _ في تحصّل الواقع المقطوع به، وذلك غير خفيٍّ؛ لأنّه طريقٌ إلى الواقع وانكشافه، ولا يمكن أن يكون الطريق سبباً لتحصّل ذي الطريق.
نعم، لا مانع من تحصّل حكم آخر وتحقّقه بواسطة هذا القطع، كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة فتصدّق. وهذا تارةً: يكون تمام الموضوع للحكم. واُخرى: يكون جزء الموضوع بأن يكون الموضوع مركّباً من وجوب الصلاة والقطع به في المثال.
فظهر من ذلك عدم إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور، وكذا في موضوع مثله ، كما لو فرضنا تعلّق الحرمة بالخمر الواقعي وتعلّق حرمة اُخرى به إذا كان مقطوع الخمرية، كقولنا: مقطوع الخمرية حرام؛ للزوم اجتماع المثلين
ص: 25
بناءً على أن يكون لازم تعلّق الحكم بش_يءٍ عروض عرضٍ عليه واتّصافه بذلك كما اختاره المحقّق الخراساني رحمه الله، فيلزم من أخذ القطع في موضوع مثل هذا الحكم اجتماع المثلين في موضوعٍ واحدٍ. وأمّا بناءً على ما اخترناه في مبحث اجتماع الأمر والنهي من عدم كون الموضوع معروضاً للحكم بمعنى عدم كون الحكم عرضاً من الأعراض، فلا مانع من أخذه في موضوع مثل هذا الحكم، فراجع.((1))
ثم إنّه قد ذكر الشيخ رحمه الله قيام الأمارات والاُصول مقام القطع الطريقي،((2)) ومراده تنجّز الواقع بها؛ لأنّ الشارع إنّما اعتبر الأمارات وكذا الاُصول المحرزة لحفظ مصلحة الواقع ، وعدم وقوع المکلّف في مفسدة الحرام الواقعي ، فالحكم يتنجّز بها كما يتنجّز بالقطع.
نعم، لو قلنا في باب الأمارات بالسببية والموضوعية وأنّ قيام الأمارة مثلاً على وجوب فعلٍ سببٌ لوجوبه ، لا مجال للقول بقيام الأمارة مقام القطع؛ لأنّ الحكم الّذي يثبت بسبب قيام الأمارة على هذا المبنى حكمٌ واقعيٌ موضوعه قيام الأمارة على وجوب هذا الفعل مثلاً، بخلاف ما هو المختار من كون الأمارة حجّة من باب الطريقية.
وليعلم: أنّ المراد من اعتبار الأمارة إنّما هو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، فمعنى قوله: «صدّق العادل» أو «اعمل بالبيّنة» هو وجوب البناء على أنّ ما أخبر به العادل واقعٌ، وترتيب آثار الواقع عليه. فلو قامت البيّنة على موضوعٍ ذي حكمٍ مثل: «إنّ هذا المائع خمرٌ» فمعنى اعتبارها ترتيب آثار الخمرية عليه، ومن جملتها حرمته ووجوب الاجتناب عنه. ولو قامت على حكمٍ شرعيٍّ، فمعنى اعتبارها إلغاء احتمال خلافه، والبناء على أنّه حكمٌ شرعي.
ص: 26
لكن يجب أن يكون الشيء الّذي قامت الأمارة عليه محتمل الوجود والعدم، وإلّا فلو كان مقطوع الوجود أو العدم فلا مجال لاعتبار الأمارة إذا قامت على أحد الطرفين.
وفي الجملة: معنى اعتبار الأمارة ليس إلّا تنزيل المؤدّى منزلة الواقع وإلغاء احتمال خلافه، وهو لا يكون إلّا في موردٍ شكّ فيه وتطرّق إليه احتمال کلّ من الوجود والعدم، وأمّا إذا قطعنا بوجود شيءٍ أو عدمه _ حكماً كان أم موضوعاً _ فلا مجال فيه للقول باعتبار الأمارة وتنزيل مؤدّاها منزلة الواقع.
وإذا عرفت ذلك تعرف أنّ معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي ليس إلّا كونها سبباً لتنجّز التكليف الواقعي، فكما أنّ في صورة القطع بشيءٍ _ حكماً كان أم موضوعاً _ يتنجّز الواقع بسببه ويستحقّ القاطع العقوبة على تركه لو صادف قطعه الواقع، فكذلك في قيام الأمارة على حكمٍ أو موضوعٍ ذي حكمٍ شكّ فيه يتنجّز التكليف بسببها أيضاً، ويستحقّ العقوبة على مخالفته لو صادفت الواقع، وفي صورة عدم المصادفة وترك العمل على مقتض_ى الأمارة فيكون متجرّياً كالقاطع.
وأنّه لا يمكن قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي؛ لأنّه إذا كان لمقطوع الخمرية بما أنّه مقطوع الخمرية حكم فلا يثبت هذا الحكم لما قامت الأمارة على كونه خمراً، لتفرّع الحكم على وجود الموضوع وهو في المقام معلوم الانتفاء، للعلم بعدم وجود مقطوع الخمرية، فالموضوع _ وهو مقطوع الخمرية _ معلوم العدم، وما قامت الأمارة عليه _ وهو هذا المائع _ ليس موضوعاً.
وممّا ذكرنا ظهر صحّة کلام الشيخ(قدس سره) وما أفاده أوّلاً بقوله: «ثم من خواصّ القطع الّذي هو طريقٌ إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية والاُصول مقامه في العمل».((1))
ص: 27
فإنّ قيام الطرق والأمارات والاُصول مقام القطع _ كما أفاد _ من خواصّ القطع الطريقي دون غيره.
وأمّا ما أفاده بعد ذلك _ ممّا يناقض بظاهره هذا الكلام _ بقوله: «بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية، فإنّه تابعٌ لدليل ذلك الحكم... إلخ»((1)) فنحن نحتمل أن يكون مراده ملاحظة الدليل الدالّ على موضوع القطع في مقام الإثبات. فإن كان راجعاً في عالم الثبوت إلى أنّ الموضوع هو متعلق القطع وأنّه ليس للقطع دخلٌ في الموضوع، وإنّما اُخذ في لسان الدليل لكونه طريقاً إليه _ كما هو المتعارف في لسان أهل المحاورة، فيقولون: إذا علمت بمجيء زيدٍ فاستقبله، فإنّه ليس للعلم بالمجيء دخلٌ في وجوب الاستقبال _ قامت الأمارة والأصل مقامه، وإلّا فلا.
والدليل على أنّ مراده هو هذا قوله: «ثم من خواصّ القطع... إلخ» وقوله: «على وجه الطريقية للموضوع»، فإنّ الظاهر أنّ مراده من الموضوع هو موضوع الحكم.
وبالجملة: فهذا أقرب الوجوه الّتي يمكن أن تقال في توجيه کلام الشيخ(قدس سره).
وقد ذكروا له وجهين آخرين:
أحدهما: (وهو الأقرب من الوجه الآتي) أنّ القطع تارةً: يؤخذ بما أنّه صفةٌ قائمةٌ بنفس القاطع وهي اطمئنانه بانكشاف الواقع وعدم تزلزله فيه. وتارةً: يؤخذ في موضوع الحكم بما أنّه صفةٌ للمقطوع به، لأنّ لازم تعلق القطع بشيءٍ وحصول الصفة القائمة بنفس القاطع عروض صفةٍ على ما قطع به ، وهي كونه مقطوعاً به منكشفاً. فلو اُخذ على النحو الأوّل لم يمكن قيام الأمارات والاُصول مقامه، ولو اُخذ على النحو الثاني قامت الأمارة مقامه.
ص: 28
ولكنّ الحقّ عدم تمامية هذا التوجيه، وقد أشار إليه وإلى جوابه في الكفاية بقوله: «وآخر بما هو صفةٌ خاصةٌ للقاطع أو المقطوع به... إلخ».((1))
ثانيهما: أنّ القطع تارةً: یؤخذ في الموضوع بما هو انكشاف لا بما أنّه صفةٌ للقاطع أو المقطوع به ، بل بما أنّه كشفٌ تامٌ للواقع. وتارةً: یؤخذ بما أنّه طريقٌ معتبرٌ إلى الواقع.
وبعبارةٍ اُخرى: يلاحظ القطع ويؤخذ في الموضوع بجهته الجامعة بينه وبين سائر الطرق المعتبرة، فملاحظته إنّما تكون من حيث كونه أحد مصاديق الطرق المعتبرة.
فعلى الأوّل لا تقوم الأمارة مقامه. وعلى الثاني لا مانع من قيام الطرق والأمارات المعتبرة مقامه.
إن قلت: إذا لم يكن العنوان الواقعي موضوعاً كما هو المفروض فدليل الحجّية لا يشمل الأمارة القائمة عليه حتى تصير مصداقاً للطريق المعتبر؛ لأنّ معنى حجّية الأمارة فرض مدلولها الواقع وترتب آثار الواقع عليه، والمفروض في المقام أنّ ما تعلّقت به الأمارة ليس له أثرٌ واقعيٌ بل الأثر إنّما يترتّب على العلم إن كان تمام الموضوع، وعلى الواقع المعلوم إن كان قيده.
قلت: ما ذكرته حقّ لا محيص عنه لو كان العلم تمام الموضوع ولم يكن لمتعلّقه أثرٌ أصلاً، ولكن إذا كان للمتعلّق أثرٌ آخر غير ما يترتّب على العلم، كما إذا كان الخمر موضوعاً للحرمة واقعاً، وما علم بخمريته موضوعاً للنجاسة، أمكن إحراز الخمر تعبّداً بقيام البيّنة ، لكونها ذات أثرٍ شرعيٍّ، وبعد قيام البيّنة يترتّب عليها ذلك الحكم الآخر الّذي يترتّب على العلم من حيث إنّه طريقٌ لتحقّق موضوعه قطعاً ، فلا مانع في مثل ذلك من قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي.
ص: 29
وأمّا لو كان العلم قيداً للموضوع فيكفي في إثبات الجزء الآخر كونه ذا أثرٍ تعليقيٍّ بمعنى أنّه لو انضمّ إلى الباقي لترتّب عليه الأثر الشرعي، وكم له من نظيرٍ، فإنّ إثبات بعض أجزاء الموضوع بالأصل أو بالأمارة والباقي بالوجدان، غير عزيزٍ.((1))
وفيه: أنّه بناءً على هذا الوجه لا معنى للقول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الّذي لوحظ فيه القطع بما أنّه أحد أفراد الطرق المعتبرة، بل الأمارة على هذا تكون كالقطع وفي عرضه لا في طوله، فلا فرق بينهما في الموضوعية ولا يقوم أحدهما مقام الآخر ، فإنّ القطع لم يؤخذ في الموضوع إلّا من حيث كونه أحد أفراد المنجّز ، فحاله وحال الأمارة واحدٌ.
وكيف كان، فأقرب الوجوه في توجيه کلام الشيخ(قدس سره) هو الوجه الأوّل. والله تعالى هو الهادي إلى الصواب والعالم به.
بعدما علم طريقية القطع للحكم الواقعي الإلزامي وموضوعيته لحكم العقل بتنجّز هذا الحكم الإلزامي، وأنّ معنى منجّزية الحكم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف المقطوع به في صورة إصابته، يقع الكلام في أنّه إذا قطع بوجوب شيءٍ أو حرمته ، فخالف مقتضى قطعه بترك ما قطع بوجوبه أو فعل ما قطع بحرمته مع عدم إصابة قطعه الواقع، لعدم كون ما قطع بوجوبه واجباً وما قطع بحرمته حراماً، هل يكون كما إذا قطع بوجوب شيءٍ وتركه وصادف قطعه الواقع أو لا؟
ص: 30
وقبل الخوض في الكلام ينبغي تحرير محلّ النزاع، فنقول: يمكن أن يكون محلّ النزاع في جهتين:
الجهة الاُولى: في الحكم الشرعي، وفيها يمكن أن يحرّر النزاع في حكم مطلق الفعل المقطوع وجوبه أو حرمته صادف القطع الواقع أم لم يصادف. ويمكن أن يحرّر في حكم الفعل المقطوع وجوبه أو حرمته إذا خالف القطع الواقع، كما أفاد المحقّق الخراسانيرحمه الله في الحاشية واستدلّ على عدم كونه محكوماً بحكم بخروجه عن تحت الاختيار،((1)) لأنّ مصادفة القطع الواقع ممّا لا تناله يد الاختيار، وبلزوم اجتماع المثلين لدى القاطع.
الجهة الثانية: في الحكم العقلي، وهو استحقاق العقاب على الفعل وقبحه، بعد معلومية عدم كون الفعل متّصفاً بالقبح مع قطع النظر عن تعلّق القطع به. وفي هذه الجهة أيضاً يمكن البحث في أنّ الفعل المتجرّئ به هل يكون قبيحاً بملاك العصيان الموجود في مخالفة القطع الّذي صادف الواقع ليكون المتجرّي أيضاً عاصياً كما يكون هو عاصياً أو لا؟
وفي أنّه هل يكون قبيحاً بغير هذا الملاك؟
وبعبارة اُخرى نقول: لا ريب في أنّه إذا تعلّق أمر المولى ونهيه بفعلٍ وإن كان فعل ما تعلّق به الأمر بحسب ذاته حسناً وما تعلّق به النهي قبيحاً وإلّا لم يقع الأوّل مورداً لأمر المولى والثاني لنهيه، ولكن بسبب تعلّق الأمر أو النهي به ينطبق عليه في صورة المخالفة عنوان يكون نفس هذا العنوان قبيحاً وملاكاً لاستحقاق العقاب، وهو
ص: 31
خروجه عن رسم العبودية وعصيانه لأمر المولى ومخالفته له، كما أنّه في صورة الموافقة ينطبق عليه عنوانٌ يكون نفس هذا العنوان حسناً وملاكاً لاستحقاق الثواب، وهو الانقياد والأداء لرسوم العبودية. فعلى هذا، يمكن وقوع النزاع في وجود هذا الملاك في الفعل المتجرّئ به وعدمه، ويمكن تحرير النزاع في أنّ الفعل المتجرّئ به هل يكون قبيحاً بغير هذا الملاك أو لا؟
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ ما يظهر من بعض کلمات الشيخ(قدس سره) هو وقوع النزاع واقعاً في الحكم العقلي، كما في قوله في مقام الجواب عن الإجماع: «أمّا الإجماع فالمحصّل منه غير حاصلٍ، والمسألة عقليةٌ».((1)) ومن بعضها أنّ النزاع واقعٌ في الحكم الش_رعي، مثل قوله: «والحاصل: أنّ الكلام في كون هذا الفعل _ غير المنهيّ عنه باعتقاده _ واقعاً مبغوضاً للمولى» إلى أن قال: «لكن لا يجدي في كون الفعل محرّماً شرعيّاً»،((2)) هذا.
ولا يخفى: أنّ ما أفاده في صدر العنوان من أنّ الكلام واقعٌ في أنّ قطعه في صورة عدم المصادفة هل يكون حجّة عليه أو لا؟((3))
ليس في محلّه؛ لأنّ الحجّة ما يكون منجّزاً للحكم فلا يمكن أن يكون موضوعاً للحكم.
وكيف كان، فالّذي ينبغي أن يقال: إنّه لا مجال للنزاع في الحكم الش_رعي للفعل المقطوع به سواء صادف القطع الواقع أم لا ، لعدم وجود دليلٍ شرعيٍّ عليه أصلاً. وأمّا حكمه الشرعي في صورة عدم الإصابة، فهو أيضاً مثله، مضافاً إلى الإشكال الّذي ذكره في الحاشية من كونه خارجاً عن الاختيار.
وهكذا لا وقع لاحتمال كون النزاع في الحكم العقلي إذا كان راجعاً إلى استحقاق
ص: 32
العقوبة وقبح الفعل بغير ما هو الملاك في قبح الفعل واستحقاق العقوبة على المخالفة في صورة الإصابة.
فالصحيح: أنّ محلّ النزاع ليس إلّا الحكم العقلي الراجع إلى أنّ ملاك القبح واستحقاق العقاب وانطباق عنوان القبيح على الفعل الموجود في صورة الإصابة هل يكون موجوداً في صورة عدم الإصابة أو لا؟
وأنت لو تأمّلت في ذلك لا تجد تفاوتاً بين الفعل المتجرّئ به والمعصية الحقيقية في انطباق عنوان كفران نعمة المولى والظلم عليه والخروج عن رسم العبودية والطغيان عليه. ولا ينافي ذلك عدم كون الفعل المتجرّئ به بنفسه قبيحاً؛ لأنّ اتّصاف الفعل بالمفسدة الذاتية غير اتّصافه بالقبح من جهة تعلّق نهي المولى به وانطباق عنوان المخالفة عليه، وهذا هو الملاك لتحقّق العصيان واستحقاق الذمّ واللوم، ولا فرق فيه بين المتجرّئ به وغيره.
لا يقال: إنّ العقاب _ كما يستفاد من الآيات والروايات _ لا يكون إلّا على المعصية الحقيقية.
لأنّه يقال: فرق بين فعلية العقاب واستحقاقه، والآيات والأخبار إنّما هي في مقام الإيعاد على فعلية العقاب وهي غير استحقاق العقاب.
إن قلت: ليس الملاك لاستحقاق العقاب إلّا الإتيان بما هو مبغوضٌ للمولى، وهو لا يتحقّق إلّا في المعصية الحقيقية دون التجرّي.
قلت: إذا كان هذا ملاكه فما هو الملاك في استحقاق العقاب بالنسبة إلى الأوامر الامتحانية الصادرة من الموالي العرفية لأجل امتحان العبيد؟ مع أنّ في صورة مخالفتها لم يأت العبد بما هو مبغوضٌ للمولى قطعاً مع كونه مستحقّاً للعقاب والتوبيخ، هذا.
ثم إنّ الشيخ(قدس سره) _ بعدما ذكر الوجوه الّتي قيلت أو يمكن أن تقال لإثبات الحكم
ص: 33
العقلي للفعل المتجرّئ به وهو قبحه وكونه موجباً لاستحقاق العقاب؛ وحكمه الش_رعي، وهو حرمته، من الإجماع، وبناء العقلاء على استحقاق العقاب، وحكم العقل بقبح التجرّي؛ وتقرير دلالة العقل _ أفاد في مقام الخدشة في الإجماع بأنّ المحصّل منه غير حاصلٍ، والمسألة عقليةٌ، والمنقول منه ليس بحجّةٍ.
وأفاد في مقام الرّد على بناء العقلاء بأنّه لو سلّم فإنّما هو على مذمّة الشخص من حيث إنّ فعله كاشفٌ عن وجود صفة الشقاوة فيه لا على نفس فعله.((1))
أقول: لا مجال لدعوى الإجماع بعد كونه حجّة لأجل قول الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، أو كشفه عن وجود نصٍّ معتبرٍ في مثل هذه المسألة الّتي لم يقع البحث عنها عند القدماء.
وأمّا ما أفاد في مقام الردّ على بناء العقلاء، ففيه: أنّا نمنع كون الفعل كاشفاً عن شقاوة العبد وكونه في مقام التمرّد والخروج عن رسم العبودية ، بل ربما يكون منشأه طغيان الشهوة وغلبة الهوى، مع عدم كونه في مقام الطغيان وعدم الاعتناء بشأن المولى، بل مع كمال ميله إلى أداء رسم العبودية كما في الدعاء:«إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحدٌ ولا بأمرك مُسْتَخِفٌ ولا لِعقوبتك مُتَعَرِّضٌ ولا لِوَعدك مُتَهاوِنٌ، ولكن خطيئةٌ عَرَضَتْ وَسَوَّلَتْ لي نفسي وغَلَبني هَوايَ وأعانني عَليها شِقْوَتي وَغَرَّني سِتْرُكَ الْ_مُرْخَى عَلَيَّ»((2))، ولذا لو وبّخه المولى على ذلك لقام مقام الاعتذار والاستغفار، كما ترى في الخطيئة الصادرة عن آدم(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) وزوجته(عَلَيْهَا السَّلاَمُ) لمّا وبّخهما الله تعالى بقوله: «أَلَ_مْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبينٌ»((3)) فإنّهما قاما مقام
ص: 34
الاعتذار و: «قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا»((1)) وهذا بخلاف صاحب السريرة الخبيثة والشقاوة ؛ فإنّه في مقام الطغيان وعدم الاعتناء بشأن المولى يكون حاله كإبليس في استكباره ومخالفته لأمره تعالى، ولذا أجاب عن قوله تعالى: «مَا مَنَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» «خَلَقْتَني مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ».((2))
هذا، مضافاً إلى أنّه لا فرق في حركة الأخلاق الرذيلة والصفات المقبّحة الشأنية من القوّة إلى الفعلية بين من صادف قطعه الواقع ومن لم يصادف؛ إذ لا تفاوت بين عزم المتجرّي وبين عزم من كان مصيباً في قطعه، وكذا بين جزمهما وإرادتهما وبين فعلهما من جهة انطباق عنوان التمرّد والطغيان عليه، ما لم تصل شقاوته إلى المرتبة الفعلية. وبعبارة اُخرى: ما لم تصل في حركتها إلى منتهاها، كما لو عزم على الفعل ولكن لم يجزم به، أو جزم ولكن منع نفسه عنه ولم يرده، لم يستحقّ العقاب. وأمّا إذا عزم وجزم وأراد بالإرادة الجدّية ووصلت شقاوته في حركتها إلى المرتبة الفعلية، فلا عذر له ويتّصف فعله بالقبح من غير فرق بين أن يكون مصيباً في قطعه أم لا؛ وإلّا فلا وجه لاستحقاقه الذمّ واللوم من جهة وجود الصفة الكامنة فيه، مع كونها ذاتية وخارجة عن تحت الاختيار وإن أمكن علاجه بالاختيار بسبب العمل بالوظائف المقرّرة في علم الأخلاق والرياضات الشرعية. ولذا لا یؤاخذ المولى عبده على عدم إقدامه لتعديل أخلاقه وإزالة الملكات الخبيثة لديه، بل یؤاخذ ويوبّخه على العمل على وفقها وما صدر منه بها، فتأمّل.
ثم إنّه قد ظهر ممّا اخترناه ضعف ما أفاد المحقّق الخراساني(قدس سره) من عدم استحقاق
ص: 35
العبد للذمّ واللوم من جهة وجود الصفة الكامنة، وأنّ الموجب لذلك والسبب لاستحقاق العقاب ليس إلّا الجري على طبقها والعمل على وفقها وجزمه وعزمه عليه مع بقاء الفعل المتجرّئ به والمنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح.((1))
وجه الضعف: أنّ الصفات الكامنة في النفس سواءٌ رجعت إلى سوء الس_ريرة وخبث الباطن أو غلبة الشهوة وطغيان الغضب وغيرهما، أم رجعت إلى الصفات الحسنة، کلّها قوّةٌ محضةٌ، ووصولها إلى الفعلية يحتاج إلى الحركة الّتي هي عبارة عن الخروج من القوّة إلى الفعل ، فإذا تهيّأت في عبدٍ موجبات خروج سوء سريرته وحركة خبث باطنه من القوّة إلى الفعلية كان الطغيان على المولى عنده محبوباً، فيعزم على ذلك ويجزم حتى إذا أراده تنتهي حركتها وسيرها إلى منتهاها، فما لم تصل إلى منتهاها ، ومَنَعها العبد عن سيرها كان منعها عنه في مرتبة وصولها إلى حدّ الحبّ والعزم أو الجزم لم يكن مستحقّاً للذمّ ولم يجز تقبيحه وتوبيخه عقلاً، أمّا بعد وصولها إلى منتهى سيرها وفعليّتها يصير الفعل قبيحاً لانطباق عنوان الطغيان عليه ، ويستحقّ الذمّ واللوم من جهة أنّه فعل فعلاً يكون له نحو ارتباطٍ بالمولى وجهة انتسابٍ إليه، بها يكون هذا الفعل قبيحاً وإن لم تكن مفسدته وقبحه ذاتية إلّا في صورة إصابة قطعه، فالملاك لاستحقاق اللوم والذمّ والعقاب ليس إلّا من جهة كون انتساب فعله إلى المولى قبيحاً. وهذا الملاك كما هو موجودٌ في المعصية الحقيقية، كذلك هو موجودٌ في الفعل المتجرّئ به أيضاً. وأمّا القبح الّذي يكون فيه لا من هذه الجهة بل من جهة نفس ذاته فهو على حاله ولا يمكن إزالته، وليس مناطاً لاستحقاق الذم والعقاب، ولا يمكن رفع أثره بالتوبة.
ص: 36
قد ظهر ممّا ذكر أنّ الفعل المتجرّئ به قبيحٌ وموجبٌ لاستحقاق العقاب، سواءٌ كان واجباً أو مستحبّاً أو مكروهاً أو مباحاً، خلافاً لصاحب الفصول (رحمه الله) فإنّه فصّل في المقام وأفاد بأنّ المتجرّي إذا قطع بتحريم شيءٍ غير محرّمٍ واقعاً استحقّ العقاب بفعله، إلّا أن يعتقد تحريم واجبٍ غير مش_روطٍ بقصد القربة فإنّه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقاً، أو في بعض الموارد، نظراً إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية. بل ربما يتّصف فعله بالحسن كما إذا اعتقد كون شخصٍ عدوّاً للمولى وكان مأموراً بقتله فتجرّأ ولم يقتله، وظهر كونه ابن المولى .
واستدلّ على ذلك بأنّ قبح التجرّي ليس عندنا ذاتياً بل يختلف بالوجوه والاعتبارات.((1))
وأفاد بأنّه على ذلك يكون التجرّي على الحرام في المكروهات الواقعية أشدّ منه في مباحاتها، وهو فيها أشدّ منه في مندوباتها. ويختلف باختلافها ضعفاً وشدّةً كالمكروهات.
ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجرّي.((2))
ولتوضيح ما أفاد وظهور الحقّ في المقام نشير إلى اُمورٍ:
أحدها: أنّ اتّصاف الأفعال بالحسن والقبح إنّما هو من جهة ترتّب المصالح والمفاسد الّتي هي ملاكات الأحكام عليها، فمن الأفعال ما لا يترتّب عليه إلّا المصلحة. ومنها: ما لا يترتّب عليه إلّا المفسدة. ومنها: ما يترتّب عليه المصلحة والمفسدة، فإذا كانت المصلحة المترتّبة على الفعل أقوى من المفسدة تتّصف بالحسن، وإذا كانت مفسدته أقوى اتّصف بالقبح. ولكن كون المصلحة أو المفسدة أقوى ليس
ص: 37
سبباً لزوال جهته الاُخرى بحيث لا تكون فيه إلّا جهة القبح أو الحسن، بل هو باقٍ على حاله من ترتّب المفسدة والمصلحة عليه. نعم، أقوائية المصلحة سببٌ لعروض عنوان الحسن عليه.
ثانيها: أنّ ما يقال بأنّ حسن بعض الاُمور أو قبحها ذاتيٌ كالعدل والظلم والإساءة إلى المحسن، إنّما هو بملاحظة نفس عنوانه، بحيث يحكم العقل بحسن هذا العنوان وعدم اتّصافه بالقبح أصلاً إذا تحقّق في الخارج، من دون أن يكون معنونه مصداقاً لعنوانٍ قبيحٍ. ولكن لا ينافي ذلك كونه مصداقاً لعنوانٍ قبيحٍ يكون قبحه أقوى من حسن هذا العنوان، وبالعكس. فعلى هذا، إن كان المراد من عدم كون قبح الفعل المتجرّئ به ذاتيّاً وإنّما يكون بالوجوه والاعتبار أنّه بحسب الوجود الخارجي وتحقّقه في فردٍ يكون مجمعاً للعنوانين يمكن أن يتّصف بالحسن، فهو كلامٌ متينٌ. وأمّا إن كان المراد من عدم كون قبحه ذاتياً أنّ قبحه ليس بذاتيٍّ حتى بملاحظة نفس عنوانه وفرض تحقّقه في الخارج مجرّداً عن تعنونه بعناوين اُخرى، فليس في محلّه، كما لا يخفى.
ثالثها: أنّ ما هو ملاك استحقاق العقاب واللوم والذمّ وصدق العصيان على الأفعال ليس إلّا الجهات الراجعة إلى المولى، وأمّا المصالح والمفاسد الّتي تترتّب عليها فلا تكون ملاكاً لذلك، ولا يكون الفعل بحسبها إلّا علّةً لوجود تلك المصالح أو المفاسد، من غير أن يكون سبباً لتحقّق عنوان العصيان وهتك حرمة المولى، وما يلازمه من استحقاق العقاب.
فملاكه ليس إلّا الجهة الراجعة إلى المولى، وليست هي إلّا انطباق عنوان مخالفة المولى والظلم عليه والخروج عن رسم العبودية وهتك حرمته وغيرها من أمثال هذه العناوين القبيحة على الفعل. ولا تتحقّق هذه العناوين إلّا بعد أمر المولى عبده أو نهيه ومخالفة العبد، حتى لو فرضنا عدم كون ملاك أمره ونهيه ترتّب المصلحة على
ص: 38
الفعل أو المفسدة، فلو أمره ومع ذلك خالف العبد يكون بفعله هذا مستحقّاً للعقاب واللوم والذمّ.
فالقبح الّذي ينطبق على الفعل من جهة كونه معنوناً بهذه العناوين لايستتبع الحكم الشرعي؛ لأنّه من آثار الحكم وما يترتّب عليه ويقع متأخّراً عنه رتبةً.
وأمّا الحسن والمصلحة والقبح والمفسدة الكامنة في الأفعال الّتي هي ملاكات الأحكام الشرعية فلها التقدّم الطبعي بالنسبة إلى الأحكام، وإذا كانت في فعلٍ مصلحةٌ ومفسدةٌ، وكانت إحداهما مرجوحةً بالنسبة إلى الاُخرى، أثّر الراجح في أمر المولى ونهيه. ولكن ليس المراد من ذلك أنّ المصلحة المرجوحة أو المفسدة المغلوبة تزول رأساً ولا تبقى على حالها، بل هما على حالهما كما كانتا. وعلى کلّ حالٍ فلا يمكن أن تكون المصلحة الكامنة في الفعل بحسب الذات مانعة عن فعلية قبحه من جهة انتسابه إلى المولى، وصحّة استحقاق عقوبته عليه.
إذا عرفت ذلك کلّه تعلم: أنّ المصلحة الذاتية الكامنة في الفعل المتجرّئ به لا تمنع عن انطباق عنوان الهتك والظلم والخروج على المولى عليه. ولا تمنع من صحّة عقاب المتجرّي واستحقاقه للذمّ واللوم.
وقد ظهر أيضاً ما في کلام صاحب الفصول(قدس سره) من تداخل العقابين في المعصية الحقيقية؛((1)) لأنّه بعد فرض كون ملاك استحقاق العقاب في المتجرّي عين ما هو الملاك في استحقاق العاصي، وأنّهما يرتضعان من ثديٍ واحدٍ، لا يبقى مجالٌ لهذا الكلام، لعدم إمكان تحقّق التجرّي والمعصية الحقيقية في موردٍ واحدٍ، ولا دخالة لمصادفة الجزم مع الواقع وعدمها في استحقاق العقاب.
ص: 39
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ مراده من تداخل العقابين فيما إذا شرب مائعاً مع القطع بكونه خمراً واتّفق كونه ماءً مغصوباً فيتداخل العقابان عقاب التجرّي وعقاب الغصب.
ولكن هذا أيضاً بعيدٌ عن الصواب؛ لأنّ حرمته الواقعية بما أنّه مغصوبٌ ليس ملتفتاً إليها لتكون ملاكاً للعقاب، فتأمّل جيّداً.
ثم إنّه لا يخفى عليك: أنّه لا فرق فيما ذكر من قبح التجرّي واستحقاق العقاب بين ما إذا كان الجزم منجّزاً للحكم الشرعي أو أمارةً من الأمارات أو أصلاً من الاُصول. بل ولو كان الاحتمال كما في الاحتمالين المذكورين في کلام الشيخ(قدس سره) وهو التلبّس بما يحتمل كونه معصية لعدم المبالاة بمصادفة الحرام، أو التلبّس برجاء أن لا يكون معصية والخوف من كونه معصية((1)) وإن لا يبعد أن يكون هذا أخفّ قبحاً من السابق.
وأمّا التلبّس به برجاء تحقّق المعصية فهو خارج عن التجرّي، بل ربما یؤول أمره إلى الكفر، كما أنّ القصد مع الاشتغال بمقدّمات الفعل سواء ارتدع عنه أو منعه مانع لا يكون تجرّياً، كما لا يخفى. والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين. اللّهم وفّقنا لما تحبّ وترضى.
تنبيه: ذكر المحقّق الخراساني(قدس سره) في هذا المقام کلاماً لا يناسب أن يصدر من مثله مع علوّ مقامه؛ لأنّه خلاف الحقّ والتحقيق، ولكنّ الجواد قد يكبو، وهو ما ذكره أيضاً في مبحث الطلب والإرادة من عدم كون الاختيار اختيارياً وإن كان بعض مباديه غالباً بالاختيار. وأنّ حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما يكون من تبعات البعد عن المولى، وهو وإن كان خارجاً عن الاختيار إلّا أنّ الذاتيات ضرورية الثبوت للذات.((2))
وهذا الكلام كما ترى يكون بظاهره خلاف ما استقرّ عليه قول أهل العدل، وقد
ص: 40
أشبعنا الكلام في جوابه في مبحث الطلب والإرادة، ومجمله: أنّ ملاك اختيارية الفعل وصحّة توبيخ المولى عبده على العصيان والمخالفة ليس مجرّد صدوره عن الإرادة في مقابل الأفعال الطبيعية القهرية وإلّا لكان الحيوان أيضاً مختاراً لأنّ فعله صادر عن الإرادة ومسبوق بها، فما هو الملاك في ذلك والمناط في باب صحّة التكليف وحسن المؤاخذة واستحقاق الثواب أنّ في الإنسان ميولاً مختلفة وغرائز متباينة فمنها الميل إلى إصلاح حال الجسم وتدبير حال البدن والاُمور الفانية الدنيوية، ومنها الميل إلى تدبير حال الروح وباطنه وإصلاح ما يتعلّق بالنشأة الآخرة، وقد أعطاه الله تعالى لأجل تشخيصه عواقب الاُمور وما يترتّب على أفعاله من المصالح والمفاسد القوّة الملكوتية العقلية، وأيّده بما أنزل على أنبيائه وبيّنه على لسانهم ، فلا يصدر من الإنسان فعل من الأفعال الإرادية إلّا وهو مسبوق بتمكّنه لملاحظة مآله وعاقبته، بخلاف الحيوان. وهذا هو الملاك في كون الفعل اختيارياً، لا مجرّد صدوره عن الإرادة.
فالحاصل: أنّ توهّم كون القرب والبعد وما هو ملاك استحقاق العقاب وصحّة توبيخ العبد راجعاً إلى الذات، فاسد جدّاً. وتدلّ على فساده _ مضافاً إلى العقل _ الآيات الكريمة والأخبار الشريفة.
قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا مَعْشَ_رَ الْ_جِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَ_مْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْ_حَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كَافِرِينَ﴾.((1))
فلو كان العقاب راجعاً إلى ما تقتضيه ذات العاصي لما كان مجال لهذا الخطاب، ولما صحّ توبيخهم بهذا التوبيخ .
ص: 41
وقال أيضاً تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ خَسِ_رُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤمِنُونَ﴾((1)) فإنّ خس_ران النفس ليس بخ_سران المال، بل المراد منه أنّهم ضيّعوا أنفسهم واتلفوا الاستعداد واللياقة الذاتيّتين اللتين أعطاهم الله تعالى إيّاهما. والآيات الدالّة على هذا المعنى كثيرة جدّاً.
وأمّا الروايات، فمنها: ما روي عن أبي جعفر(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال : «ما من عبد إلّا وفي قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطّي البياض، فإذا غطّى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾((2))».((3))
ومنها: ما روي عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «ما من مؤمن إلّا ولقلبه في صدره اُذنان في جوفه: اُذن ينفث فيها الوسواس الخناس، واُذن ينفث فيها الملك، فيؤیّد الله المؤمن بالملك، وذلك قوله: ﴿وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾.((4))
ومنها: ما روي أيضاً عن أبي عبد اللّه (عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «ما من قلب إلّا وله اُذنان على أحدهما ملك مرشد، وعلى الاُخرى شيطان مفتن، هذا يأمره، وهذا يزجره ، الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره عنها، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾».((5))
ص: 42
ومنها: ما روي في كيفيّة خلق الإنسان بقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «إنّ الله عزّ وجلّ لمّا أراد أن يخلق آدم بعث جبرئيل في أوّل ساعة من يوم الجمعة، فقبض بيمينه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنيا وأخذ من کلّ سماء تربة، وقبض قبضة اُخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى _ إلى أن قال: _ ثم إنّ الطينتين خلطتا جميعاً... إلخ».((1))
ومنها: ما ورد في أنّ لكلّ واحد من العباد بيتاً في الجنّة وبيتاً في النار، وقد فسّ_ر به قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ * الّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوسَ...﴾.((2))
ومثل هذه الروايات كثيرة متفرّقة في أبواب كتب الحديث، وكلّها تدلّ على أنّ للإنسان قوّة يتمايل بها إلى العالم الروحاني والتشبّه بالملائكة والروحانيّين وكسب العادات الباقية وفعل الأعمال الحسنة، وقوّة بها يتمايل إلى العالم الجسماني وحظوظ النفس البهيمية، وأنّ حقيقته تركّبت من جزءين: جزء من العالم العلوي، وجزء من العالم السفلي، وأعطاه الله تعالى _ لتمييز الصلاح _ القوّة العاقلة، فلا يصدر منه فعل
ص: 43
من الأفعال الإرادية إلّا بعد تصويب العقل. وهذا هو ملاك اختيارية الأفعال، والفرق بين الإنسان والحيوان، كما لا يخفى. فافهم واغتنم عصمنا الله تعالى من الزلل، وغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان بحقّ محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين .
هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في كونه منجّزاً وموجباً لاستحقاق العقوبة على المخالفة أو لا؟
وبعبارة اُخرى: إذا علم العبد بحرمة المائع المردّد بين المائعين، أو علم بوجوب إحدى الصلاتين (الجمعة أو الظهر). سواء كانت الشبهة موضوعية، كما إذا علم بخمرية أحد المائعين. أو حكمية، كما إذا تردّد تكليفه بين القصر والتمام ، أو بين الظهر والجمعة. فهل يكون علمه هذا منجّزاً للتكليف المعلوم في البين أو لا؟
نسب إلى المحقّق الخوانساري(قدس سره) والقمّي(قدس سره) عدم تنجّزه به مطلقاً،((1)) وجواز المخالفة القطعية، وسيجيء الكلام فيما في هذه النسبة.
وذهب الشيخ(قدس سره) إلى كونه علّة تامّة لعدم جواز المخالفة القطعية، ومقتضياً لوجوب الموافقة القطعية،((2)) بمعنى أنّه لو لم يمنع من اقتضائه مانع وارتكب المخالفة
ص: 44
الاحتمالية وصادف المعصية استحقّ العقاب، ولكنّ للشارع المنع من اقتضائه بالنسبة إلى الموافقة القطعية والإذن في المخالفة الاحتمالية.
واختار المحقّق الخراساني(قدس سره) كونه مقتضياً مطلقاً، فيجوز أن يمنع الشارع من اقتضائه ويرخّص العبد حتى في المخالفة القطعية.((1))
وهنا وجه آخر هو المختار، وهو: كون العلم علّة تامّة لتنجّز التكليف المعلوم بالإجمال، فلا يجوز الترخيص في المخالفة وإن كانت احتمالية.
وأمّا الوجه الثالث من الوجوه المذكورة في کلام الشيخ(قدس سره) وهو الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز في الأوّل دون الثاني،((2)) فلم أقف على وجود قائل به، كالوجه الرابع، وهو: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحداً بالنوع كوجوب أحد الشيئين وبين اختلافه كوجوب شيء وحرمة آخر.((3))
وقبل الخوض في الكلام ينبغي التنبيه على أمر وهو: أنّه لا ريب في اُصولية البحث عن حجّية العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي.
ولا اعتناء بما في بعض الكلمات من أنّ النزاع في العلم الإجمالي إنّما يكون من المسائل الاُصولية إن كان مرجعه إلى إثبات الحكم به وعدمه، وأمّا إن كان راجعاً إلى استحقاق العبد للعقاب في صورة المخالفة، فهو بالمسائل الكلامية أشبه.
فإنّ المراد من أشبهيته بالمسائل الكلامية إن كان هو النزاع في جواز عقابه وعدم قبحه حتى يرجع النزاع إلى ما يصحّ صدوره عنه وما يمتنع.
ففيه: أنّ المبحوث عنه في الكلام جواز صدور فعل القبيح عن الله تعالى وعدمه _
ص: 45
فجوّزه الأشعري لإنكاره الحسن والقبح العقليّين، وأنّ الحسن ما صدر منه والقبيح ما لم يصدر، وأنكره العدلية _ ولا يبحث في علم الكلام عن مصاديق ذلك وخصوصياته.
وإن كان المراد أنّ النزاع يرجع إلى المباحث المتعلّقة بالمعاد، من جهة انتهاء هذا المبحث إلى البحث عن فعلية العذاب في الآخرة وعدمها.
ففيه: أنّ المبحوث عنه في المعاد ليس إلّا أصل المعاد والجزاء والثواب والعقاب والعذاب، ولا يبحث فيه عن فعلية العذاب بالنسبة إلى كلّ واحد من المعاصي؛ لأنّ فعلية العذاب ليس أمراً يمكن الاطّلاع عليه بخصوصياته.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ الحكم كما ذكرنا سابقاً هو إنشاء الخطاب ليكون باعثاً للعبد وسبباً لتحرّكه، أو زاجراً له وموجباً لانتهائه عن الفعل، ولا تتمّ سببيّته لذلك وعلّيته للانبعاث إلّا في ظرف وصوله إلى العبد، فما لم يصل إليه لا يترتّب عليه الانبعاث أو الانزجار، ولا تتحقّق له المرتبة الفعلية، بل ليس له إلّا الشأنية والصلاحية لأن ينبعث العبد به، ويصير فعليّاً في ظرف الوصول. وليس عدم صيرورته فعلياً في ظرف عدم وصوله إلى العبد مع كونه صالحاً لأن يكون باعثاً للعبد لقصور في ناحية الحاكم، بل لقصور الخطاب وعدم إمكان صيرورته سبباً للانبعاث في صورة الجهل، ولذا لا يريد الآمر انبعاث العبد بذلك الخطاب المتكفّل لهذا الحكم إلّا في صورة وصوله وعلم العبد به، مع كون حكمه مطلقاً وغير مقيّد بالعلم والجهل؛ فإنّ تقييده بالعلم موجب للدور، وبالجهل تكليف بالمحال. ولذا لا مانع من أن يوجب المولى الاحتياط أو ينصب طريقاً له في صورة الاحتمال حتى ينبعث العبد بأمره هذا بعد وصوله إليه أيضاً نحو التكليف الواقعي. وليس هذا إلّا من جهة عدم تقييد الحكم بالعلم والجهل؛ لأنّه لو كان مقيّداً بالعلم لما كان مجال للخطاب الثاني رعاية للخطاب الأوّل، كما لا يخفى.
ص: 46
لا يقال: لا يتوقّف انبعاث العبد بالأمر على العلم به ووصوله إليه بل يكفي في ذلك احتمال الأمر.
فإنّه يقال: إنّ انبعاثه باحتمال الأمر أو تخيّل الأمر ليس انبعاثاً بالأمر؛ فإنّه لا يتحقّق إلّا في ظرف العلم ووصول الحكم إلى مرتبة الفعلية لأجل وصوله إلى العبد.
والحاصل: أنّ وصول الحكم إلى العبد موجب لفعليّته وترتّب الانبعاث عليه، بل ليس فعليّته غير وصوله إليه، فبعد وصول الحكم إلى هذه المرتبة لا مجال لعدم كونه فعلياً. ولا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والإجمالي؛ لأنّه على الفرض ليس لفعليته مانع إلّا عدم وصوله إلى العبد ، وبعد وصوله لا مجال لعدم فعليته وترتّب الانبعاث أو الانزجار عليه ، سواء كان المعلوم مجملاً أم لا. فالحكم كمايكون موجباً لتحريك العبد وباعثاً له نحو الفعل إذا علم بالتكليف تفصيلاً ، كذلك يكون باعثاً له أيضاً إذا علم به إجمالاً.
ولا مجال للقول بعدم إمكان انزجاره به مثلاً من جهة التردّد في المائع المعلوم حرمته بين المشتبهين. لإمكان انزجاره بتركهما معاً.
نعم، إذا كانت الشبهة بدوية حيث لم يصل الحكم فيها إلى العبد ، لايمكن ترتّب الانبعاث أو الانزجار عليه، فلا يكون فعلياً وإن كان له شأنية ذلك، كما مرّ.
والحاصل: أنّا إذا فرضنا علم العبد بأنّ المولى بعثه بعثاً أكيداً إلى فعل معيّن ، ولا يرضى بتركه هذا الفعل ، ولكن متعلّق هذا البعث الأكيد والإرادة الحتمية اشتبه بين شيئين ، فالوجدان حاكم بلزوم الإتيان بالمشتبهين تحصيلاً لما هو مطلوب المولى؛ لعدم وجود قصور في بعثه وخطابه ، وإمكان موجبيّته لانبعاث العبد وصلاحيته لتحريكه كما في العلم التفصيلي.
فلو لم يأت العبد بما هو مطلوب المولى لتركه کلا المشتبهين، وعاقبه المولى على مخالفته هذه وعصيانه وخروجه عن رسم العبودية لم يكن ظالماً ولا عقابه عقاباً بلا برهان.
ص: 47
وكذا إذا ترك ما هو مطلوب المولى من جهة تركه أحد المشتبهين مع إتيانه بالآخر ، واتّفق كون ما تركه هو الواجب فللمولى أن يعاقبه على ذلك ، لتحقّق عصيانه وخروجه عن رسم العبودية، فهو عند العقل مستحقّ للعقاب.
فلو فرضنا أنّ أحد عبديه ترك کلّ واحد من المشتبهين وارتكب المخالفة القطعية ، والآخر لم يترك إلّا واحداً منهما وارتكب المخالفة الاحتمالية ولكن اتّفق كون المتروك هو الواجب في البين، فالعقل يحكم باستحقاقهما للعقاب على وزان واحد ، من غير فرق بين من ارتكب المخالفة القطعية ، ومن ارتكب المخالفة الاحتمالية مع عدم كون الواجب ما أتى به. ولا نعني بتنجّز التكليف المعلوم بالإجمال وفعليته إلّا هذا.
ثم إنّه قد ظهر ممّا ذكر أنّه لا يتمّ القول بجواز المخالفة الاحتمالية مع جعل البدل؛((1)) فإنّ جعل البدل إن كان في مقام الواقع بأن يجعل شيئاً عدلاً له ولو بخطاب آخر في صورة عدم العلم التفصيلي بالمكلّف به، فيرجع إلى الوجوب التخييري، فيكون المکلّف مخيراً بينهما ، وهو خارج عن محلّ الفرض ، لأنّ الكلام واقع فيما إذا علم وجوب شيء معيّن وبعث المولى نحوه مع تردّد متعلّقه بين شيئين ، دون أن يكون کلّ واحد منهما متعلّقاً لبعثه وزجره على سبيل الترديد النفس الأمري. هذا، مضافاً إلى أنّ الشيخ(قدس سره) لا يجوّز أخذ العلم بالموضوع في حكم نفس هذا الموضوع،((2)) كأن يقال: إذا جزمت بالجزم التفصيلي بوجود الخمر فاجتنب عنه.
وإن كان المراد جعل البدل في مقام الظاهر، فبعد فرض فعلية الحكم الواقعي وعدم
ص: 48
مانع عن انبعاث العبد به لا مجال لجعل البدل في مقام الظاهر والالتزام بشأنية الحكم وتأخّره عن مرتبة الفعلية الّتي وصل إليها.
وما في بعض الكلمات من انحفاظ موضوع الحكم الظاهري في مورد العلم الإجمالي ، فإنّ موضوعه إنّما يكون الشكّ في التكليف وهو موجود بالنسبة إلى کلا المشتبهين.
ففيه: أنّ جعل الحكم الظاهري كما ذكرنا إنّما يصحّ في مورد يكون الخطاب المتكفّل للحكم الواقعي قاصراً عن بعث المکلّف نحو الفعل أو زجره عنه ، والشكّ الّذي يكون موضوعاً للحكم الظاهري إنّما يكون كذلك إذا كان ملازماً لشأنية الحكم الواقعي وقصور خطابه عن البعث أو الزجر لا مطلقاً. ففي الحقيقة يكون موضوع الحكم الظاهري شأنية الحكم الواقعي وقصور خطابه عن بعث العبد وتحريكه نحو الفعل وإن كان هذا ملازماً للشكّ في الحكم الواقعي.
ثم إنّه قد تلخّص من جميع ما ذكرناه أنّه في مورد العلم الإجمالي بالتكليف والقطع بتعلّق إرادة المولى على سبيل الحتم بفعل شيء أو تركه ، لا مجال للقول بصحّة جعل البدل وجواز المخالفة ، لعدم الفرق بين المخالفة الاحتمالية والقطعية في ذلك. ولا يوجب تردّد هذا الشيء _ المعيّن المتعلّق لإرادة المولى _ بين شيئين صحّة جعل البدل وتجويز المخالفة ، مع حفظ العلم بتعلّق إرادته الحتميّة به ، من غير فرق في ذلك بين الشبهة المحصورة وغيرها.
إن قلت: إنّ تجويز المخالفة والاكتفاء بأحد الطرفين واقع في الش_رع، مثل موارد إجراء قاعدة الفراغ، وغيرها.
قلت: قد حقّقنا في مبحث الإجزاء((1)) أنّ دليل قاعدة الفراغ ونظائرها من القواعد إنّما تجعل المأتيّ به الناقص في ظرف الشكّ فرداً للمأمور به كالفرد التامّ الأجزاء، ولا
ص: 49
فرق بينهما في الامتثال والإجزاء، فلا يكون بدلاً عن الواقع ليكون المأمور به غيره واكتفى الشارع به عنه.
ثم إنّه لا يذهب عليك: أنّ ما نسب إلى المحقّق الخوانساري والقمي(قدس سره) من القول بعدم تنجّز التكليف إذا تعلّق به العلم الإجمالي.
ليس في محلّه؛ فإنّ مرادهما عدم تنجّز التكليف إذا قامت عليه حجّة إجمالية غير العلم ، فإنّ التكليف بشيء معيّن مشروط بالعلم التفصيلي بذلك الشيء ، لأنّ الطاعة لا تحصل إلّا بقصد التعيين، فلو أراده المولى ولم يبينه لزم تأخير البيان عن وقت الحاجّة ، فلا يتنجّز التكليف بالحجة الإجمالية. ولا ضير في مخالفة هذا التكليف الّذي قام عليه غير القطع من الحجج الإجمالية، إلّا إذا قام عليه إجماع كالإجماع القائم على عدم جواز ترك صلاتي الظهر والجمعة معاً بأن لا يأتي بواحدة منهما.
وأمّا إذا علم إجمالاً بأنّ المولى أراد فعلاً معيناً بالإرادة الحتمية غير المش_روطة بش_يء من العلم بذلك الشيء، فلا يسعه إلّا تحصيل الموافقة القطعيّة.
فالمحقّقان المذكوران موافقان لنا في تنجّز التكليف إذا تعلّق به العلم الإجمالي.
وأمّا إذا كان غير العلم من الحجج مجملاً ، فلا مانع من جواز المخالفة القطعية فضلاً عن الاحتمالية، مثلاً: إذا تردّد الخمر بين مائعين، وكان دليل وجوب الاجتناب عن الخمر المعيّن في البين إطلاق «اجتنب عن النجس» أو «لا تش_رب الخمر». أو دار الأمر بين وجوب صلاة الظهر والجمعة من جهة قيام رواية على وجوب الظهر وقيام رواية اُخرى على وجوب الجمعة، ولم نقل بتساقطهما بالتعارض. فلا مانع فيما إذا كان من هذا القبيل من تجويز المخالفة الاحتمالية بل والقطعية ، وسيجيء إن شاء الله تعالى توضيح ذلك في مبحث البراءة مفصّلاً.
هذا کلّه في إثبات أصل التكليف بالعلم الإجمالي.
ص: 50
ثم إنّه حيث ذكر القوم هنا حكم الامتثال الإجمالي وكفاية الاحتياط، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحقّ في المقام، ولتوضيح المرام نقول:
إعلم: أنّه وإن كان ظاهر بعض الكلمات ربما يوجب توهّم كبروية النزاع ، ولكن لا ريب في فساده؛ لأنّه لا مجال للقول بعدم كفاية الاحتياط والامتثال الإجمالي ، فإنّ الاحتياط عبارة عن الإتيان بالمأمور به بجميع ما احتمل دخله فيه جزءاً وشرطاً من غير إخلال بش_يء منه ، بحيث يعلم مع الإتيان به بإتيان ما هو المطلوب للمولى وعدم الإخلال بشيء ممّا اعتبر واُخذ فيه شرطاً أو شطراً ، وكفايته غير قابلة للنزاع.
فمحلّ النزاع والكلام إنّما هو في الصغرى وإمكان الاحتياط وعدمه في موارد:
أحدها: فيما إذا علم دخل شيء في المأمور به شرطاً أو شطراً، وشكّ في أنّ دخله فيه هل هو على نحو الوجوب أو الاستحباب؟ فاختلفوا في تحقّق الاحتياط مع الإتيان بالجزء المشكوك في وجوبه واستحبابه من جهة الإخلال بقصد الوجه الّذي احتمل دخله فيه.
ص: 51
متعلّقه القصر أو التمام ، فهل الإتيان بهما بداعي الأمر المتعلّق بأحدهما المعيّن واقعاً يكفي في حصول الامتثال؟ مع أنّ حاله حين الإتيان بكلّ منهما يكون حال من كان شاكّاً في أصل تعلّق الأمر بأمر معين معلوم خارجاً ، لأنّه لا يعلم كون هذا مأموراً به أم لا، وإن علم بعد الإتيان بهما بالإتيان بالمأمور به.
خامسها: فيما إذا شكّ في الجزء المأمور به بالأمر الضمنيّ مع دوران أمره بين المتباينين، كالجهر والإخفات. وهذا نظير القسم الرابع إلّا أنّ داعي الإتيان في هذا القسم _ بكلّ من الجزءين _ هو الأمر الضمني الّذي تعلّق بأحدهما بخلاف القسم الرابع ، فإنّ داعيه هو الأمر النفسي.
إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا في القسم الأوّل فلا إشكال في صحّة الاكتفاء بالاحتياط والامتثال الإجمالي ولو قلنا باعتبار قصد الوجه في المأمور به. ووجهه يظهر ممّا ذكرناه في مبحث الصحيح والأعمّ من أنّ الصلاة عنوانٌ عرضيٌ مقولٌ بالتشكيك ذو مراتب ودرجاتٍ مختلفة في الشدّة والضعف والنقص والكمال، يصدق على مصاديقها المختلفة في الكمال والتمامية ، فالفرد الّذي يتحقّق في ضمن تحقّق الأجزاء الواجبة والمستحبّة فردٌ لها ومعنون لهذا العنوان العرضي، كما أنّ الفرد الخالي من الأجزاء المستحبّة مصداق لها أيضاً، ففي کلّ واحد من المصاديق تكون حقيقتها محفوظة. فعلى هذا، يكون ما هو مصداق الصلاة برتبتها الكاملة الشديدة بتمام أجزائه مأموراً به ، وكلّ جزء من أجزائه يكون واقعاً تحت الأمر بالكلّ ومتعلّقاً للأمر الضمني الّذي تعلّق به من جهة الأمر بالكلّ، من غير فرق بين الأجزاء الواجبة والمستحبّة.
كما أنّ ما هو مصداقها بغير هذه المرتبة مع فقده لجميع الأجزاء المستحبّة يكون معنوناً بعنوان الصلاة ، ويكون کلّ جزءٍ منه مأموراً به بالأمر الضمني ، وإن كان انطباق هذا العنوان على ما هو جامع لجميع الأجزاء المستحبّة والواجبة أولى من غيره.
ص: 52
فبناءً على ذلك لا مانع من قصد وجوب الكلّ من جهة كونه مصداقاً للصلاة ، وقصد وجوب أجزائه بالوجوب الضمنيّ، ولو لا ذلك لما أمكن تصور معنى صحيحٍ لاستحباب الأجزاء المستحبّة.
وبالجملة: ليس معنى استحباب شيء في الصلاة إلّا أنّ المکلّف لو أتى بها في ضمن فردٍ فاقد للجزء المستحبّ غير صادق عليه الصلاة بمرتبتها الكاملة كان مجزياً عنها مع كونه فاقداً لهذا الشيء المستحبّ، ولم يكن لأجل فقدانه هذا الجزء مصداقاً للصلاة بمرتبتها الكاملة. ولو أتى بها في ضمن فرد كان واجداً للجزء المستحبّ انطبق عليه الصلاة بالمرتبة الكاملة.
وأمّا ما أفاد بعض من عاصرناه _ من الأعاظم في مجلس ساعدنا التوفيق على الالتقاء به _ في تصوير الأجزاء المستحبّة من أنّ للصلاة ماهيتين إحداهما: المرکّبة من الأجزاء الواجبة وهي: الصلاة الواجبة المشتملة على التكبير والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء الواجبة. وثانيتها: المرکّبة منها ومن الأجزاء المستحبّة، وهي: الصلاة المستحبّة المتضمّنة للصلوات الواجبة.
ففيه: ما أوردنا عليه في المجلس المذكور بأنّ الصلاة لو كانت ماهيّة صادقة على جميع الأجزاء والشرائط الواجبة ، فالأجزاء المستحبّة ليست منها لا محالة. وإن كانت مركّبة من الأجزاء المستحبّة والواجبة ، فلازمه تعلّق الأمر بما هو المرکّب من الأجزاء والشرائط الواجبة والمستحبّة وهو منافٍ لاستحباب الأجزاء المستحبّة.
هذا کلّه في إمكان الاحتياط في القسم الأوّل. وأمّا غيره من الأقسام وما يمكن أن يقال بكونه مناطاً لعدم إمكان الاحتياط فيه غير ما يقال بكونه مناطاً في القسم الأوّل ، وهو لزوم الإخلال بقصد الوجه، لإمكان تحقّق قصد الوجه في هذه الأقسام وصفاً وغايةً، فلو دار الأمر بين المتباينين يحصل قصد الوجه إذا أتى بهما بقصد الصلاة
ص: 53
الواجبة عليه من بينهما، أو بقصد الصلاة المردّدة بينهما لوجوبها. فإنّ قصد الوجه ليس إلّا قصد المأمور به من حيث وجوبه واستحبابه ، فلا مانع من تحقّقه فيما نحن فيه ، لإمكان قصد الوجه بعد معلومية وجوب الصلاة المردّدة بينهما أو استحبابها.
فما يمكن أن يقال بكونه مناطاً لعدم تمشّي الاحتياط ليس إلّا الإخلال بقصد القربة لا قصد الوجه، لما ذكرنا. ولا قصد التعيين والتمييز؛ لأنّ المراد من دخل قصد التمييز إن كان توقف تعيين بعض الأفعال وتميّزها عن الآخر بالقصد لكونه من العناوين القصدية الّتي لا تتحقّق إلّا به، كالتعظيم والظهرية والعصرية وغيرها، فلا ربط له بما نحن فيه؛ لأنّ المأمور به إذا كان من هذا القبيل لا يتحقّق إلّا إذا أتى به مع القصد، ولا ينطبق عليه إلّا إذا أتى به كذلك.
وإن كان المراد أنّ قصد التعيين موجب لتعيّن المأمور به وتميّزه عن غيره ، فمن الواضح أنّ تميّزه وتعيّنه لا يتوقّف على قصد التعيين؛ لأنّه بنفسه متعيّن ومتميّز عن غيره. ولا دخل لمعلومية كون الواجب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في تميّزه، لأنّه متميّز عن غيره علم المکلّف به أم لم يعلم.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد من اعتبار قصد التمييز هو أنّ عدم معلومية المأمور به ولو بكونه مردّداً بين المتباينين موجب للإخلال بقصد القربة ، فإنّه لا يتحقّق إلّا إذا أتى بالفعل بداعي أمره المعلوم تعلّقه به، لا ما إذا أتى به بداعي الأمر الّذي تردّد متعلّقه بين الفعلين.
فعلى هذا، تمام الإشكال في غير القسم الأوّل من الأقسام راجع إلى لزوم الإخلال بقصد القربة وعدم كفاية قصد التقرّب بما هو المطلوب من بينهما في تحقّق الامتثال والاحتياط.
ولا فرق في ذلك بين القول باعتبار قصد الوجه وعدمه.
فعلى القول باعتباره يشكل في كفاية الإتيان بالواجب المعيّن المردّد ظاهراً بين شيئين
ص: 54
بداعي التقرّب إلى الله تعالى في تحقّق الاحتياط، لعدم كفاية ذلك مع عدم قصد التقرّب بما هو مأمور به بالخصوص حين الإتيان به.
وعلى القول بعدم اعتباره يشكل كفاية الإتيان بما علم مطلوبيته إجمالاً _ إمّا بنحو الوجوب أو الاستحباب _ في تحقّق الاحتياط إذا أتى به بداعي الأمر المردّد متعلّقه بين المتباينين.
وكيف كان، فالّذي ينبغي أن يقال في دفع هذا الإشكال هو: أنّ الفاعل إذا أتى بالفعل بداعي المحبوبية أو امتثال الأمر بحيث كان محرّكه إلى الفعل تحصيل التقرّب إليه، لا مجال للقول بعدم كفاية ذلك في الامتثال وحصول التقرّب. ولا نعني بالتقرّب والتعبّد إلّا أن يكون داعيه نحو العمل أمر المولى أو محبوبية الفعل أو غيرهما من الوجوه الّتي يمكن أن يقال بكفايته لتحقّق التقرّب ، ولذا لو أتى بأحد المشتبهين بهذا الداعي وتبيّن قبل الإتيان بالآخر كونه هو المأمور به ، يكتفي به ولا يلزم الإتيان بالآخر.
ولا فرق فيما ذكر بين القول بتوصّلية المأمور به وتعبّديته تمسّكاً بالأصل اللفظي؛ لأنّ الأمر إنّما صدر ليكون داعياً نحو المتعلّق، أو بالأصل العملي وهو الاشتغال لوقوع الشكّ في كفاية الإتيان بالمتعلّق في حصول الغرض.
ووجه عدم الفرق هو أنّ کلامنا في المقام فيما تثبت عباديّته ، وقد ظهر لك إمكان الاحتياط في الموارد الّتي ذكرناها من غير إخلال بقصد القربة.
إن قلت: نعم، لا مانع من تحقّق قصد القربة مع الامتثال الإجمالي، ولكن من الممكن أن تكون معلومية الواجب في الخارج وعدم اشتباهه معتبرة في المأمور به.
قلت: لا وقع لهذا الاحتمال مع عدم وجود أثر له في الأخبار؛ لأنّ اعتباره كذلك مع عدم ذكره إخلال بالغرض، فمقتضى البراءة نفي اعتبار ذلك فيه، وإن لم يمكن نفيه بسبب التمسّك بإطلاق المتعلّق ، لأنّ العلم بالمأمور به متأخّر عن الأمر ، فلا يمكن أخذه في متعلّقه.
ص: 55
إن قلت: إنّ الإجماع قائم على عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي.((1))
قلت: إنّ دعوى قيام الإجماع في مثل هذه المسألة _ الّتي لم يبحث عنها في كتب القدماء بل ذكرها المتأخّرون في كتبهم ، والظاهر أنّ أوّل من تكلّم فيها صاحب «الإشارات»((2)) _ مجازفة جداً.
ولو اُريد منه بناء المتش_رّعة على الامتثال التفصيلي وجريان سيرتهم عليه دون الامتثال الإجماليّ.
فليس ذلك من جهة عدم صحّة الاكتفاء به ولا كاشفاً عنه ، بل استقرار سيرتهم عليه إنّما هو لموافقته للطبع والعادة، لأنّ في الامتثال الإجمالي کلفة ليست هي في التفصيلي.
إن قلت: نعم، لا مانع من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي إذا لم يستلزم التكرار، وأمّا إذا استلزم التكرار فلا يجوز الاكتفاء به، لكونه لعباً بأمر المولى.((3))
قلت: لا اعتناء بهذا الإشكال؛ لأنّ عدم كونه لعبا بأمر المولى _ ولو استلزم التكرار _ بمكان من الوضوح.
ثم لا يخفى عليك: أنّه كما لا مانع من حصول التقرّب إذا كان المأمور به مردّداً بين شيئين بإتيان کلّ منهما بداعي الأمر الّذي تعلّق بأحدهما المعين المردّد في الظاهر وتحقّق الاحتياط فيه، لا مانع أيضاً من حصوله لو أتى بهما بداعي امتثال الأمر الّذي احتمل تعلّقه بأحدهما.((4))
ص: 56
هذا کلّه في كفاية الامتثال الإجمالي والموافقة الإجمالية مع التمكن من الموافقة التفصيلية. وأمّا كفايته في صورة تعذّر الامتثال التفصيلي وإمكان الامتثال الظنّي ، سواء كان بالظنّ المعتبر أم لا ، فلا ريب فيه.
هذا تمام الكلام في القطع، وسيأتي الكلام في غيره من المباحث إن شاء الله تعالى.
وفّقنا الله تعالى لطاعته وطاعة رسوله وأوليائه صلواته عليهم، وغفرلنا ولوالدينا ولأساتيذنا جميعاً بحقّ محمد وآله الطاهرين. اللّهمّ صحّح بلطفك نيّاتنا، واستصلح بقدرتك ما فسد منّا، وارزقنا عافية الدنيا والآخرة، وصلّ على محمد وعترته الطاهرة يا أرحم الراحمين.
ص: 57
ص: 58
في بيان ما يكون منجّزاً من الأمارات، أو قيل بكونه كذلك
وقبل الخوض في البحث لابدّ من تقديم اُمور:
إنّه وإن كان البحث في كتب القدماء واقعاً في إمكان التعبّد بخبر الواحد، إلّا أنّ ملاك النزاع _ كما ذكره المتأخّرون _ يعمّه وسائر الأمارات، فلا وجه لتخصيصه به.
في بيان ما هو مرادهم من الإمكان المذكور في عنوان البحث، فنقول:
إعلم: أنّه تارة: يطلق الإمكان، ويراد منه الإمكان الذاتي وهو على قسمين:
أحدهما: الإمكان الذاتي الخاصّ ويطلق على ما كان ممكناً ذاتاً وليس فيه اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم، وفي مقابله الوجوب الذاتي الّذي يطلق على ما كان بحسب ذاته ضروريّ الوجود، والامتناع الذاتي الّذي يطلق على ما كان بحسب ذاته ضروريّ العدم.
ثانيهما: الإمكان الذاتي العامّ ويطلق على ما كان سلب أحد طرفي الوجود والعدم
ص: 59
فیه ضروریا، وسلب ضروره طرف الوجود یجامع الامتناع والامکان، وسلب ضروره طرف العدم یجامع الوجوب والامکان.
واُخرى: يطلق الإمكان ويراد منه الإمكان الاستعدادي وهو تهيّؤ الش_يء ليصير شيئاً آخر، باعتبار نسبته إلى الشيء المستعدّ له ، كما يقال: الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة. وهذا غير الاستعداد ، فإنّه يقال على تهيّؤ الش_يء باعتبار نسبته إلى الش_يء المستعدّ، كما يقال: إنّ النطفة مستعدّة للإنسانية.
وثالثة: يطلق ويراد منه الإمكان المذكور في کلام الشيخ الرئيس وهو الاحتمال،((1)) ويعبّر عنه في لسان الاُصوليّين بالإمكان الذهني.
ورابعة: يطلق ويراد منه الإمكان الوقوعي بالمعنى المصطلح عند الاُصوليّين، وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه ولا وقوعه محال ، وفي مقابله الوجوب والامتناع الوقوعيّان. وأهل المعقول يعبّرون عن هذا الإمكان أيضاً بالإمكان الاستعدادي.
وربما يطلق الإمكان ويراد منه الإمكان الاستقبالي؛ لأنّ الش_يء بوجود علّته يكون ضروريّ الوجود وبعدمها ضروريّ العدم، فلا يصحّ إطلاق الإمكان عليه إلّا بلحاظ الاستقبال.((2))
وفيه: أنّه لا تفاوت بين إطلاق الإمكان بلحاظ الحال وإطلاقه بلحاظ الاستقبال؛ لأنّه بلحاظ الاستقبال أيضاً يكون ضروريّ الوجود بوجود علّته وضروری العدم بعدمها.
ص: 60
وكيف كان لا إشكال في أنّ مرادهم من الإمكان المذكور في كلماتهم في المقام ليس هو الإمكان الذاتي بكلا معنييه، ولا الإمكان الاستعدادي ، ولا الإمكان المذكور في کلام الشيخ الرئيس، بل هو الإمكان الوقوعي،((1)) فتدبّر.
لا يخفى عليك: أنّه لا أصل في المقام يتمسّك به عند الشكّ في الإمكان الوقوعي. ولا فائدة في تأسيسه لعدم ترتّب أثر عليه، إذ مع قيام الحجّة على اعتبار الأمارة يجب الأخذ بها، ومع قيامها على عدم اعتبارها فلابدّ من رفع اليد عن الدليل الظاهر في اعتبار الأمارة، ومع عدم قيام الحجّة على اعتبارها لا تترتّب ثمرة على تأسيس الأصل.
إن قلت: إنّ الأصل عدم التعبّد بالأمارة وغيرها من الأحكام الظاهرية.((2))
قلت: أوّلاً: أنّ هذا الأصل إنّما يجري بعد إحراز المقتضي، وهو مفقود في المقام.
وثانياً: أنّ الإمكان ليس أثراً شرعياً حتى يثبت بهذا الأصل.
وثالثاً: أنّه لو سلّم ذلك فليس هذا الأصل غير الاستصحاب مع عدم معلومية الحالة السابقة فيه، لعدم معلوميّة وجود المانع من التعبّد بالأمارة وعدمه في الزمان السابق حتى يستصحب.
في بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في استحالة التعبّد بخبر الواحد وغيره من الأمارات بل وغيرها من الأحكام الظاهرية. والجواب عنه.
ص: 61
فاعلم: أنّه قد حكى عن ابن قبة الاستدلال على عدم جواز التعبّد بخب_ر الواحد بوجهين.((1))
الأوّل: أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لجاز التعبّد به في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعاً.
وهذا كما ترى قياس استثنائي مركّب من شرطية متّصلة وحملية، حكم فيها ببطلان التالي وهو: أنّه لا يجوز في الإخبار عن الله تعالى، فالإخبار عن النبيّ مثله. واستدلّ لبطلان التالي بالإجماع.
والّذي ينبغي أن يقال فيه: إنّ المراد بجواز التعبّد بالإخبار عن الله تعالى إن كان جواز تصديق المتنبّي ولو لم يظهر لإثبات نبوّته بيّنة وآية، فهذا أمر بطلانه ثابت بحكم العقل واتّفاق العقلاء ، ولا معنى للتمسّك بالإجماع لإثبات بطلانه إلّا أنّ الملازمة بين المقدّم والتالي محلّ الإنكار لعدم كونهما من باب واحد وعدم مناسبة وارتباط بينهما ، فإنّ المدّعي في باب حجّية خبر الواحد جواز التعبّد بالخبر مع الدليل لا بدون الدليل حتى يدّعی الملازمة.
وإن كان المراد من جواز التعبّد في الإخبار عن الله تعالى جوازه مع قيام الدليل عليه، كما لو أخبر النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) _ الّذي ثبتت نبوّته بالمعجزة والآية _ بوجوب تصديق المتنبّي في إخباره عن الله تعالى ، فلا يبعد جوازه ولا مجال لدعوى الإجماع على بطلانه.
ويظهر من المحقّق الخراساني(قدس سره) في الحاشية أنّ المراد بالإخبار عن الله تعالى _ المذكور في التالي _ ليس إخبار المتنبّي ، بل المراد أنّه لو جاز التعبّد بالخبر عن النبيّ لجاز
ص: 62
التعبّد به عن الله، كما إذا قال النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كلّما أخبر سلمان عن الله تعالى، فاعملوا به. ولذا قال لا مانع منه ولا دليل على امتناعه، ولكن لا دليل على وقوعه.((1))
ولكنّ الظاهر أنّ المراد ما ذكرناه ، لأنّ ابن قبة كان من علماء العامّة ثم استبص_ر وصار من الخاصّة ، وبعيد أن يكون مراد مثله ما زعمه(قدس سره).
الوجه الثاني: أنّ العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيته حراماً وبالعكس.
والّذي ينبغي أن يقال في تقرير هذا الدليل وتشريحه: إنّ القائل بجواز التعبّد بخبر الواحد أو الأمارة أو أحد طرفي الشكّ إمّا أن يقول بأنّه ليس لله تعالى أحكامٌ متعلّقة بالأشياء بعناوينها الأوّلية يشترك فيها العالم والجاهل أو لا، والأوّل هو التصويب المجمع على بطلانه ، مضافاً إلى دلالة الأخبار المتواترة عليه ، وعلى الثاني فإمّا أن يقول بأنّ حكم الله تعالى وإن كان بالنسبة إلى العالم والجاهل سواء ، إلّا أنّ قيام الأمارة يكون سبباً لتغيّر الحكم عمّا هو عليه وارتفاعه، أو لا يقول بذلك، والأوّل هو التصويب الانقلابي، وهو وإن كان دون الأوّل في الفساد ، إلّا أنّ الإجماع أيضاً قائم على بطلانه مع دلالة الأخبار المتواترة عليه، وعلى الثاني (وهو القول بأنّ لله تعالى أحكاماً متعلّقة بالأشياء بعناوينها الأوّلية يشترك فيها العالم والجاهل من غير فرق بين قيام الأمارة على طبقها أو على خلافها، وعِلم المکلّف وجهله بها) يلزم من التعبّد بالأمارة أو أحد طرفي الشكّ إمّا محذور اجتماع المثلين لو كان الحكم الظاهري موافقاً للواقع، وهو محال، وإمّا محذور اجتماع الضدّين في صورة مخالفة الحكم الظاهري مع الواقعي ، والتكليف بالمحال لو كان الحكم الواقعي واجباً والظاهريّ حراماً مثلاً ، وتفويت
ص: 63
المصلحة الملزمة لو أدّت الأمارة إلى حرمة ما هو واجب واقعاً، والإلقاء في المفسدة لو أدّت إلى وجوب ما هو حرام واقعاً.
هذا، مضافاً إلى أنّ الأحكام ظاهرية كانت أم واقعية إنّما هي تابعة للملاكات والمصالح ، فالواجب الواقعي إنّما وجب بملاحظة وجود مصلحة ملزمة فيه ، والحرام الواقعي إنّما حرم لوجود مفسدة شديدة فيه ، فلو أدّت الأمارة إلى حرمة الواجب الواقعي ، فإمّا أن تكون حرمته بعد قيام الأمارة عليها بلا ملاك ، أو تكون مع الملاك من جهة وجود المفسدة الشديدة ، وعلى الثاني فالمصلحة الملزمة المؤثّرة في الحكم الواقعي _ وهو الوجوب _ إمّا أن تكون مغلوبةً لهذه المفسدة بحيث تؤثّر هذه المفسدة في رفع أثر المصلحة في الوجوب ، فلا مجال لكون الفعل محكوماً بالوجوب واقعاً ، بل هو حرام ظاهراً وواقعاً ، وإن كان بالعكس فلا مجال لكون الفعل حراماً ظاهراً ، بل هو واجب ظاهراً وواقعاً ، وإن لم تكن لأحدهما غلبة على الآخر ، بل كان الملاكان على السواء من غير تفاوت بينهما ، فلا وجه للحكم بالوجوب والحرمة.
وكيف كان، فلا يكاد يفهم معنى معقول للحكم الظاهري مع محفوظية الحكم الواقعي وكونه بحاله.
إذا عرفت حقيقة هذا الاستدلال فاعلم: أنّه بعد ما بيّنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي((1)) وغيره من المباحث السابقة من عدم كون الحكم عارضاً لفعل المکلّف وعدم كون معروضه الفعل الخارجي ، بل إنّما هو عرض يقوم بنفس المولى قياماً صدورياً؛ لأنّه لو كان عارضاً لفعل المکلّف للزم وجود العرض قبل المعروض ، فإنّ الحكم موجود قبل صدور الفعل عن المکلّف. ولا اعتناء بما قيل من لزوم محذور اجتماع المثلين في صورة إصابة الأمارة، لعدم استلزام أداء الأمارة إلى ما كان موافقاً للواقع لاجتماع
ص: 64
المثلین فی صالمثلين في صورة إصابة الأمارة، لعدم استلزام أداء الأمارة إلى ما كان موافقاً للواقع لاجتماع المثلين أصلاً.
فما هو المهمّ من المحاذير المذكورة ليس إلّا محذور اجتماع الضدّين، ومحذور اجتماع تمامية ملاك الحرمة مثلاً مع تمامية ملاك الوجوب إذا قامت الأمارة على حرمة ما يكون واجباً واقعاً، فنقول بعون الله تعالى:
أمّا الجواب عن محذور لزوم اجتماع الملاكين بناءً على الوجهين المذكورين في کلام الشيخ(قدس سره)،((1)) _ وهو كون الملاك في باب حجّية الأمارات والتعبّد بها راجعاً إلى كونها طرقاً محضة ، وعدم كون مصلحة في حجّيتها إلّا حفظ مصلحة الواقع ورعايتها ؛ لأنّه ليس في باب التعبّد بالأمارات وجعل حجّيتها تأسيساً من الشارع _ فأظهر الأمارات وأوضحها الظواهر وخبر الواحد، مع أنّا لو تأمّلنا في جميع ما استدلّوا به على حجّية الخبر مثلاً لوجدناه خالياً عن تأسيس ذلك ، بل ليس فيه إلّا ما يدلّ على ردع الشارع عن بعض الموارد ، ويفهم من هذه الأدلّة كآية النبأ((2)) وجود العمل على طبق الأمارة وبناء الناس واستقرار سيرتهم عليه ، وإنّما ردع الشارع عنه فيما إذا كان المخبِر مثلاً فاسقاً، فحجّية الأمارة ليس إلّا من جهة إمضاء الشارع ما عليه البناء وعمل العقلاء، ومن الواضح أنّ عملهم به ليس إلّا لمجرّد كونه طريقاً إلى الواقع.
فالشارع حيث لم يرد انبعاث الجاهل من الخطاب، لأجل عدم إمكان انبعاثه منه وقصوره عن ذلك؛ فإنّ الانبعاث مشروط بالوصول فمع عدم وصول الحكم إلى المکلّف لا يريد الحاكم انبعاثه منه _ وليس معنى ذلك تقييد الحكم بصورة العلم ، لأنّ علم المکلّف بالحكم متأخّر عن الحكم ، فلا يمكن أن يكون الحكم مقيّداً به _ فالحكم
ص: 65
ينشأ مطلقاً _ ومعنى إطلاق عدم لحاظ علم العبد وجهله به في مقام إنشائه، لا ملاحظة إطلاقه بالنسبة إلى العالم والجاهل _ فلابدّ للمولى الّذي يريد إيصال عبده إلى المصالح الواقعية وحفظه عن الوقوع في المفاسد الواقعية من جعل حكم وإنشاء خطاب آخر كإيجاب العمل بالاحتياط أو العمل بخبر الواحد _ إذا كان في العمل بالاحتياط عس_ر ، وهذا إنّما يصحّ فيما إذا كانت إصابة الأمارة بنظر الشارع أغلب من غيرها ، لأنّ في صورة كون غيرها كذلك يكون جعل الأمارة قبيحاً، وفي صورة تساوي الطرفين يكون لغواً ، وحيث إنّه ليست في إيجابه العمل بالخبر مثلاً مصلحة إلّا إيصال المکلّف إلى المصالح الواقعية ، ففي صورة الإصابة ليس الحكم إلّا الحكم الواقعي ، وفيما أخطأ لا يكون حكماً حقيقياً في البين بل يكون صورياً، ولمّا لم يتمكّن المکلّف من التفرقة والتمييز بين الأمارة المصيبة وبين غيرها فلابدّ من جعلها طريقاً مطلقاً حتى في صورة عدم الإصابة، إلّا أنّه في هذه الصورة ليس جعلاً وحكماً واقعياً بل يكون صورياً محضاً، وليس له ملاك أصلاً. نعم، يكون له ملاك بحسب أصل الجعل الّذي تعلّق بالأمارة، فهو باعتبار بلا ملاك، وباعتبار آخر ذو ملاك. وكيف كان، ليس فيه ملاك الحرمة في صورة الخطأ إذا أدّت إلى الحرمة، وملاك الوجوب إذا أدّت إلى الوجوب أصلاً.
وممّا ذكرنا ظهر: دفع إشكال لزوم تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة؛ فإنّ المصلحة إنّما تفوت لأجل جهل المکلّف بالواقع وكذا الوقوع في المفسدة، ولا دخل لجعل الأمارة وعدمه في ذلك.((1)) مضافاً إلى أنّه لا مانع من جلب الخير الكثير إذا كان مجامعاً ومستلزماً للشرّ القليل.
إن قلت: إنّ هذا إنّما يتمّ لو قلنا بانسداد باب العلم، وأمّا في صورة الانفتاح فلا.
ص: 66
قلت: فرق بين انفتاح باب الجزم وانفتاح باب العلم بالواقع، فيمكن أن يرى العبد انفتاح باب علمه بالواقع مع كون علمه هذا جهلاً مركباً، ولا مانع من جعل الطريق بعد ما يرى المولى عدم إصابة علم عبده وكونه جهلاً مركّباً مطلقاً أو في أغلب الموارد.
هذا کلّه إذا قلنا في باب الطرق والأمارات بالطريقية المحضة، كما هو أحد الوجهين المذكورين في کلام الشيخ(قدس سره).
وأمّا على القول بالموضوعية والسببية: فإن اُريد منه أنّ أداء الأمارة يوجب حدوث مصلحة في المؤدّي مع عدم كونه في الواقع ذا مصلحة ومفسدة ، حتى يكون الحكم مطلقاً تابعاً للأمارة ، بحيث لا يكون في حقّ الجاهل مع قطع النظر عن الأمارة حكم، فهو تصويب باطل عقلاً ونقلاً وإجماعاً.((1))
وإن اُريد منه أنّ لله تعالى أحكاماً مشتركة بين العالم والجاهل، ولكن بسبب قيام الأمارة على خلافها تحدث في الفعل مفسدة غالبة على مصلحة الواقع ، أو مصلحة غالبة على المفسدة الواقعية، حتى يكون مرجعه إلى تغيير الحكم الواقعي عمّا هو عليه بسبب قيام الأمارة على خلافه ، فهو أيضاً تصويب باطل بالإجماع والروايات المتواترة.
ولو اُريد منه أنّ قيام الأمارة لا يصير سبباً لتغيير الواقع ، ولا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل ، ولا توجب حدوث مصلحة فيه ، ولا يكون نفس سلوك الطريق والعمل بالأمارة مشتملاً على مصلحة موجبة لإيجاب الشارع العمل على طبقها ليكون ملاك جعل الأمارة المصلحة السلوكية، بل المصلحة إنّما هي في نفس الأمر بالسلوك والعمل على طبق الطريق والأمارة ، كما هو المذكور في بعض نسخ
ص: 67
«الفرائد» المطبوع قرب وفاة الشيخ(قدس سره)((1)) واختاره المحقّق الخراساني(قدس سره) في الكفاية((2)) بزعم عدم ابتناء الأحكام على المصالح في المأمور بها وكفاية وجود المصلحة في نفس الأمر، وعدم خروج ذلك عمّا استقرّ عليه رأي أهل العدل من ابتناء الأحكام على المصالح والمفاسد النفس الأمرية.
ففيه: أنّا لا نتصوّر وجود المصلحة في نفس الأمر مع عدم وجودها في المأمور به؛ لأنّه لا يمكن تحقّق الأمر والنهي من دون وجود مصلحة في المأمور به ، فالأمر إنّما يصدر لأجل التسبّب إلى وقوع المأمور به وانبعاث المکلّف نحوه وحصوله في الخارج، وليست له نفسية واستقلال ، بل وجوده لا يكون إلّا آلة وتبعاً لوجود المأمور به. ولو فرض استقلاله وعدم لحاظه كذلك، فهو خارج عن حقيقة الأمر والبعث. ولا تفاوت بين الأمر والنهي والإرادة والكراهة، فكما أنّ الإرادة لا نفسية لها ولا استقلال، وليست تلحظ إلّا بتبع المراد، ولو فرض استقلالها وملاحظتها مستقلّة لخرجت عن كونها إرادة، كذلك الأمر لا نفسية له ولا استقلال ، لأنّه متفرّع على إرادة وقوع المأمور به في الخارج ويصدر للتسبيب له ، فلو صدر لغير هذا يخرج عن كونه أمراً.
هذا، مضافاً إلى أنّه لو سلّم ذلك فلا تتدارك بهذه المصلحة، المصلحة الفائتة على المکلّف، ولا معنى لتداركها بها.
نعم، لا مانع من أن يقال بأنّها توجب تدارك المفسدة المترتّبة على نفس هذا الأمر بالسلوك، لكونه سبباً لتفويت الواقع أو وقوع المکلّف في مفسدة الحرام الواقعي،
ص: 68
فيتحقّق الكسر والانكسار بين هذه المصلحة وتلك المفسدة ويترجّح جانب المصلحة لكونها أقوى.
وإن كان المراد من القول بالموضوعية أنّ الأمارة لا توجب تغيير الواقع ، بل هو على حاله إلّا أنّ المصلحة إنّما تكون في سلوك الطريق المجعول ، ويكون نفس العمل بالأمارة مشتملاً على مصلحة موجبة لإيجاب الشارع العمل على وفقها، كما هو المذكور في بعض نسخ الفرائد المطبوع أوّلاً ، وإن كان قد نقل عنه بعض تلامذتهرحمه الله رجوعه عن هذا الوجه _ لما أورد عليه بعض تلامذته _ واختياره إمكان كون المصلحة في نفس الأمر بالسلوك، كما هو المذكور في بعض نسخه المطبوعة في سنة (1280).
وكيف كان، ففيه: أنّه ليس السلوك الّذي تترتّب عليه المصلحة خارجاً غير العمل على طبق الأمارة وإتيان مؤدّاها ، فالمصلحة تترتّب على المؤدّى لا بما أنّه مؤدّى، بل بما أنّه سلوك الطريق والعمل على طبق الأمارة، وهذا يرجع إلى الوجه الثاني.
وتفصيل الكلام فيه: أنّ الأمارة إمّا أن تؤدّي إلى وجوب ما هو حرام واقعاً أو استحبابه، أو إلى حرمة الواجب الواقعي أو إلى كراهته، أو إباحة الحرام الواقعي، أو إلى غيره من الصور المفروضة في المقام. فلو أدّت إلى وجوب الحرام الواقعي فالمصلحة الّتي تترتّب على سلوك الأمارة إنّما تترتّب على هذا الفعل الّذي هو حرام واقعاً ، لأنّه لا معنى لسلوك الأمارة إلّا إتيان هذا الفعل حيث إنّه معنونه ، فهذه المصلحة السلوكية إمّا أن تكون غالبة على مفسدة الواقع ، فلا معنى لكون الفعل حراماً واقعاً بل هو واجب واقعاً؛ وإمّا أن تكون مغلوبة للمفسدة الواقعية، فلا معنى لكونه واجباً بل هو حرام واقعاً؛ وإمّا أن تكون مساوية لمفسدة الواقع، فيجب أن لا يكون حراماً ولا واجباً.
وأمّا لو أدّت إلى حرمة الواجب الواقعي، فإمّا أن يقال بترتّب المفسدة على الفعل الّذي يكون واجباً واقعاً، فمع تقدير غلبته على المصلحة الواقعية لا يكون غير الوجه الثاني؛ ولو قيل بترتّب مصلحة على الترك تتدارك بها مصلحة الواقع، فالترك ليس قابلاً لترتّب مصلحة عليه.
ولو أدّت الأمارة إلى استحباب ما هو الواجب واقعاً، فيجب أن يصير سبباً لتأكّد مصلحة الوجوب، لا أن يكون مزاحماً لها، وفي صورة الترك لا يعقل ترتّب مصلحة عليه.
وهكذا لو أدّت إلى كراهة ما هو حرام واقعاً.
ص: 69
وأمّا لو أدّت إلى إباحة الحرام الواقعي، أو الواجب الواقعي، فلا معنى لترتّب المصلحة على الفعل الّذي أدّت الأمارة إلى كونه مباحاً. وقس على هذا سائر الفروض الّتي تكون من هذا القبيل.
نعم، هنا فرض آخر ربما يكون السبب لتوهّم المصلحة السلوكية، وهو فيما إذا أدّت الأمارة إلى وجوب صلاة الجمعة مثلاً، مع كونها حراماً واقعاً وكون الواجب الواقعي صلاة الظهر، فتتدارك بالمصلحة السلوكية المصلحة الفائتة وهي مصلحة صلاة الظهر، والمفسدة الّتي وقع المكلّف فيها وهي مفسدة ارتكاب الحرام الواقعي.
ولكن ليس حال هذا الفرض خارجاً عن سائر الفروض؛ لأنّه بعد فرض عدم وجود واجب غير إحدى الصلاتين فإمّا أن تكون المصلحة المترتّبة على صلاة الجمعة غالبة على مفسدة فعلها وفوت مصلحة صلاة الظهر فيجب أن يكون الواجب الواقعي صلاة الجمعة، وإمّا أن تكون مساوية لهما فلا معنى لوجوب إحدى الصلاتين إلّا على وجه التخيير، هذا.
ويمكن أن يقال: إنّ القول بالموضوعية والسببية على هذا الوجه ربما لا يكون خالياً عن المناقضة، فإنّ مرجعه إلى الأمر بسلوك الطريق الّذي في سلوكه مصلحة بما أنّه
ص: 70
طريق إلى الواقع وسلوكه، ولازم ذلك ملاحظة الطريق موضوعاً للحكم على نحو يكون فانياً في ذي الطريق، وملاحظته في مقابل ذي الطريق وبحياله.
وكيف كان، فنحن لم نتعقّل وجهاً للوجه الثالث الّذي ذكره الشيخ(قدس سره)، ولا نفهم تفاوتاً وفرقاً بينه وبين الوجه الأوّل على نحو لا يرجع إلى التصويب المجمع على بطلانه.
ولا يخفى عليك: أنّا لم نجد أحداً من المحقّقين قال بالسببية والموضوعية في باب الأمارات والطرق.
وأنّ لازم القول بالموضوعية كون مؤدّى الأمارة حكماً واقعياً لا ظاهرياً. فالقول بالحكم الظاهريّ إنّما يكون صحيحاً على القول بالطريقية ليس إلّا. هذا کلّه فيما يرجع إلى المحذور الملاكي، ودفعه.
وأمّا الكلام في المحذور الخطابي وهو لزوم اجتماع الضدّين، كاجتماع البعث مع الزجر، أو البعث الأكيد مع الزجر إذا كان غير الأكيد، أو عكس ذلك، أو البعث أو الزجر مع الترخيص.
فما قيل في دفعه وجوه:
أحدها: ما عن السيّد العلّامة الميرزا الشيرازي، وتلميذه المحقّق السيّد محمد الأصفهاني. ومرجعه إلى عدم وجود التضادّ بين الحكم الظاهري والواقعي لاختلاف مرتبتهما، واجتماع الضدّين إنّما يكون ممتنعاً لو تحقّق في شيء واحد وفي مرتبة واحدة.
بيان هذا الوجه: أنّ ما هو الموضوع للحكم الواقعي ليس موضوعاً إلّا بعنوانه الأوّلي النفس الأمري ولا يكون متعلّقاً بالمكلّف إلّا بعنوانه الأوّلي، فالحكم يتعلّق بموضوعه وبالمكلّف بما هما عليه من العنوان الأوّلي الواقعي النفس الأمري، وإطلاقه يشمل تمام الحالات الّتي تعرض للموضوع أو للمكلّف قبل تعلّق الحكم بهما، ولا يشمل الحالات والأوصاف المتأخّرة عن الحكم، كالعلم والجهل والشك، فلا يمكن
ص: 71
لحاظ الموضوع مقيّداً بالعلم أو الجهل به، ولا ملاحظة إطلاقه بالنسبة إليهما؛ وما هو الموضوع للحكم الظاهريّ إنّما هو الموضوع بعنوان كونه مجهول الحكم أو مشكوك الحكم، فتكون مرتبته متأخّرة عن الحكم الواقعي، ومع هذا الاختلاف في الرتبة لا مانع من تعلّق البعث بأحدهما والزجر بالآخر. ألا ترى أنّ في مسألة الترتّب ليس ملاك تصحيح طلب الضدّين إلّا اختلاف مرتبتهما، فإنّ الأمر بالأهمّ إنّما تعلّق بأحد الضدّين مطلقاً، لكن لا يشمل إطلاقه الحالات الّتي تعرض الموضوع بعد تعلّق الحكم به كالعصيان، فلا يشمل إطلاقه ما هو الموضوع للأمر بالمهمّ لأنّه مقيّد بعصيان الأهمّ.
أقول: يمكن أن يقال بأنّ موضوع الحكم الواقعي وإن لم يشمل إطلاقه حال العلم والجهل بالإطلاق اللحاظي _ لأنّ ما لا يمكن لحاظ تقييده لا يمكن لحاظ إطلاقه _ إلّا أنّه بإطلاقه الذاتي محفوظ في ظرف الشكّ والجهل بالحكم الواقعي.
وقد بيّنّا في المطلق والمقيّد((1)) أنّ معنى الإطلاق ليس إلّا إرسال الموضوع وعدم كونه مقيداً بقيد، بمعنى كون الطبيعة تمام متعلّق الحكم، خلافاً لما ذهب إليه جماعة من الاُصوليّين ومنهم المحقّق الخراساني(قدس سره)، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الإطلاق عبارة عن جعل الموضوع آلة لملاحظة الخصوصيات،((2)) ولازم ذلك ملاحظة الخصوصيات وهذا عين التقييد.
وأمّا على ما اخترناه يكون الموضوع مطلقاً بالنسبة إلى جميع حالاته سواء كانت من الحالات المفروض وجودها قبل تعلّق الحكم به ككون الصلاة مثلاً في مكان كذا وزمان كذا، أو بعده كالجهل والعلم والعصيان، فإطلاقه هذا محفوظ حتى في مرتبة الشكّ والجهل.
ص: 72
ولا يقاس ما نحن فيه بمسألة الترتّب، فإنّ ما هو الملاك في صحّة القول بالترتّب وعدم كون طلب الضدّين من قبيل التكليف بالمحال _ الّذي هو الملاك في استحالة الأمر بالضدّين بعد كون الأمر بكل واحد منهما في حدّ ذاته ممكناً _ أنّ المولى حيث يرى أنّ بعثه ليس ممّا لا ينفكّ عنه المبعوث إليه لإمكان عدم انبعاث عبده منه، ولكن يمكن أن ينبعث العبد من الأمر بالمهمّ لأجل خصوصية تكون فيه فيأمر بالمهم مش_روطاً بعصيان الأهمّ وفي ظرف عدم تأثير أمره بالأهمّ في انبعاث العبد وعدم قابليته لذلك حتى لا يكون زمان عصيانه فارغاً. وهذا ممّا لا يرى العقل مانعاً منه والوجدان حاكم بصحّته وإمكانه، فلا ينبغي أن يقاس بما نحن فيه، فإنّ تعلّق أمرين بشيئين يمكن الإتيان بكل واحد منهما في ظرفه أمر ممكن بخلاف مسألتنا هذه، فإنّ التكليف الأوّل محفوظ حال التكليف الثاني.
هذا، مضافاً إلى أنّه لو كان ملاك إمكان الأمرين بالضدّين وعدم انتهائه إلى التكليف بالمحال اختلاف مرتبة الحكمين يكون عنوان أحدهما مقيداً ومش_روطاً بعصيان الآخر، فيجب الالتزام بإمكانه إذا كان أحدهما مش_روطاً بإطاعة الآخر أو العلم به، مع اتّفاق الكلّ على عدم إمكانه.
ثانيها: ما أفاده المحقّق الخراساني(قدس سره) في الحاشية،((1)) بعد إفادة مقدمة ذكر فيها مراتب الحكم، وهو: أنّ التضادّ بين الأحكام إنّما يتحقّق فيما إذا وصلت إلى مرتبة الفعلية، وهي المرتبة الثالثة من المراتب الأربع الّتي ذكرها(قدس سره) للحكم، وأمّا في المرتبة الاُولى والثانية فلا تضادّ بينها ولا تزاحم بين إنشاء الإيجاب وإنشاء التحريم.
وعلى هذا، نقول: لا مضادّة بين الحكم الظاهري والواقعي، إذ البعث الفعلي أو
ص: 73
الزجر الفعلي لا يكون إلّا بالنسبة إلى مؤدّى الأمارة، وأمّا الحكم الواقعي فلم يصل بعدُ إلى مرتبة الفعلية لعدم وصوله إلى المكلّف وعدم تجاوزه عن مرتبة الإنشاء، وقد مرّ عدم التنافر بين الحكم الإنشائي والفعلي.
إن قلت: إنّ تصوير الحكم الواقعي بهذه المرتبة وإن كان بمكان من الإمكان إلّا أنّه لا يدفع إشكال لزوم التصويب المجمع على بطلانه.
قلت: كما يكون الإجماع قائماً على اشتراك العالم والجاهل، كذلك الإجماع قائم على عدم فعلية الأحكام بالنسبة إلى جميع المکلّفين، كالجاهل بالحكم _ الّذي تقوم عنده الأمارة مع خطأها _. فالحكم بحسب المرتبتين الأُوليين لا يختلف بحسب اختلاف الآراء والأزمان، وأمّا بحسب المرتبة الثالثة والرابعة فالإجماع قائم على اختلافه.
فإن قلت: إذا لم يكن الحكم الواقعي الّذي اشترك فيه الجاهل والعالم فعلياً، فلا يجب اتباعه إذا تعلّقت به الأمارة وأصابت، ولا قبح في مخالفته، ضرورة عدم لزوم متابعة الخطاب التحريمي أو الإيجابي ما لم يصل إلى حد الزجر أو البعث الفعلي، وإنّما يجب اتّباع الأمارة فيما لو كان مؤدّاه حكماً فعلياً لا حكماً شأنياً.
قلت: وإن كان ما أفاد في الحاشية((1)) في مقام الجواب عن هذا الإشكال ليس كافياً في دفعه، لكنّه أفاد أخيراً في دفع هذا الإيراد: أنّ للحكم في مرتبة الفعلية درجتين، الاُولى: ما يعبّر عنها بفعلية ما قبل التنجز، والثانية: ما يعبّر عنها بفعلية حال التنجّز، والاُولى عبارة عن البعث أو الزجر إذا لم يصل إلى المکلّف ولم يتعلّق به علمه، والثانية عبارة عن مرتبة وصوله إليه، فعلى هذا إذا تعلّقت الأمارة بالحكم في هذه المرتبة تجب موافقته وتقبح مخالفته.((2))
ص: 74
وقد أوردوا على هذا الوجه أيضاً بأنّه إن كان المراد من الحكم الشأني والمرتبة الشأنية مجرد الإنشاء من غير أن يكون للمولى بعث وزجر وترخيص فعلاً، كأن يكون له طومار مثبت فيه الأحكام الراجعة إلى عبيده مع عدم مخاطبتهم بها، فلا يدفع ما أفاده إشكال لزوم التصويب المجمع على بطلانه، لأنّ الحكم في هذه المرتبة ليس حكماً حقيقة.
وإن كان المراد من شأنية الحكم أنّه کلّما وجد موضوعه في الخارج يكون محكوماً بهذا الحكم، فلا يرفع به محذور اجتماع الضدّين، كما لا يخفى.
ولكن لنا أن نقول جواباً عن هذا الإيراد: إنّ تقييد الأحكام بالعلم موجب للدور، وبالجهل لغو؛ لأنّ في ظرف العلم لا يكون المکلّف معنوناً بعنوان الجاهل، وفي ظرف الجهل لا فائدة له، فالحاكم ينشأ مطلقاً ومن غير تقييد بصورة العلم والجهل ولكن لا يريد انبعاث المكلّف إلّا في ظرف العلم به لعدم إمكان انبعاثه في غير هذا الظرف. وهذا لا يكون لقصور في ناحية الحاكم وبعثه وزجره، بل لأجل القصور في ناحية الخطاب. فلو أراد الآمر انبعاثه مطلقاً يجب أن يتوسّل بأمر آخر مثل إيجاب الاحتياط أو جعل الطريق أو غيرهما. فالحكم الواقعي الّذي يشترك فيه العالم والجاهل هو الحكم الّذي أنشأه مطلقاً وإن كان المولى لم يرد انبعاث العبد منه إلّا في ظرف وصوله إليه لعدم إمكان انبعاثه إلّا في ظرف العلم به، وإنّما توسّل بإيجاب الاحتياط أو جعل الطريق لحصول غرضه وهو انبعاث العبد في ظرف الجهل أيضاً.
وأظن أنّ هذا مراد المحقّق الخراساني(قدس سره) من الحكم الفعلي في مرحلة ما قبل التنجّز، وهو المناسب لكلامه.
ثالثها: ما أفاده المحقّق المذكور في الكفاية:((1))من أنّ ما هو المجعول في باب الطرق
ص: 75
والأمارات ليس إلّا الحجّية، والحجّية المجعولة غير مستتبعة للأحكام التكليفية، وفائدة جعل الحجّية تنجّز التكليف في صورة الإصابة وصحّة الاعتذار في صورة الخطأ، فلا منافرة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي؛ لأنّ الأوّل وضعيّ غير مستتبع للحكم التكليفي، والثاني تكليفيّ محض، فلا مضادّة بين جعل الأمارة حجّة وبين وجوب فعل أو حرمته أو استحبابه أو كراهته أو إباحته.
والحاصل: أنّ معنى وجوب العمل على طبق الأمارة ليس إلّا جعلها حجّة. ولا فرق بين القطع _ وهو الحجّة الذاتية _ في كونها سبباً لتنجّز التكليف إذا أصابت وصحّة الاعتذار بها في صورة الخطأ وكون موافقتها انقياداً ومخالفتها تجرّياً، وبين الحجّة المجعولة، فإنّها أيضاً تكون كالحجّة الذاتية.
فبناءً عليه ليس في موارد الطرق والأمارات حكم من الأحكام الخمسة التكليفية حتى يستلزم محذور اجتماع الضدّين في صورة الخطأ واجتماع المثلين في صورة الإصابة، بل ليس إلّا الحكم الوضعي المجعول بجعل الشارع كسائر الاُمور الاعتبارية الوضعية نحو الملكيّة وغيرها.
رابعها: ما أفاده المحقّق المذكور أيضاً((1)) بناءً على الإباء عن الوجه السابق، والقول باستتباع جعل الحجّية للأحكام التكليفية، أو القول بأنّه لا معنى لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام وانتزاع الحجّية من الأحكام التكليفية، فإنّ وجوب اتّباع الأمارة ينحلّ إلى وجوب الفعل إذا كان مؤدّاها وجوبه، وحرمته إذا كان المؤدّى حرمته، ومن هذا ينتزع تنجّز الواقع في صورة الإصابة ومعذورية المکلّف في صورة الخطأ.
وهو: أنّ اجتماع الحكمين وإن كان يلزم إلّا أنّهما ليسا بمثلين ولا ضدّين؛ فإنّ
ص: 76
وجوب اتّباع الأمارة طريقيّ له مصلحة بحسب نفسه وهو رعاية الواقع ووصول المکلّف إلى الواقعيات، من دون أن تكون بالنسبة إلى متعلّقه بحسب كونه مؤدّى للطريق إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة، بل أُنشأ لأجل طريقيته إلى الواقع رعايةً لحفظ الواقع من جهة كون موارد إصابته أكثر من الطرق الّتي يستعملها العبد كالقطع وغيره.
فبناءً على هذا، إذا قامت الأمارة على وجوب شيء أو حرمته مثلاً ففي صورة الإصابة ليس في البين حكمٌ وإرادةٌ إلّا الحكم الواقعي والإرادة الواقعية، وأمّا الحكم الظاهري فيكون فانياً فيه فناء الطريق في ذي الطريق والمرآة في المرئيّ، وفي صورة الخطأ ليس في البين إلّا حكم ظاهريّ صوريّ من غير أن يكون متعلّقاً لإرادة المولى وكراهته، ومن غير أن تكون له في نفسه مصلحة لعدم كونه طريقاً إلى الحكم الواقعي، وإنّما أمر المولى عبده به صورةً لأجل عدم إمكان تميّز موارد إصابة الأمارة وعدمها، فأمر باتّباع الأمارة مطلقاً حفظاً لما تعلّق به غرضه من حفظ الواقعيات في موارد الإصابة. فعلى هذا، لا يلزم محذور اجتماع المثلين ولا الضدّين، لأنّه في صورة الإصابة يكون الحكم الظاهري مندكّاً وفانياً في الحكم الواقعي، وفي صورة الخطاء لا يكون الحكم الظاهري إلّا صوريّاً محضاً.
ولا يخفى عليك الفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني؛ فإنّ الوجه الثاني مبنيّ على القول بفعلية الحكم الظاهري وإسقاط الحكم الواقعي عن الفعلية، وهذا الوجه مبنيّ على كون الحكم الواقعي فعلياً وعدم كون الحكم الظاهري حكماً كسائر الأحكام.
هذا کلّه في تقرير الوجوه الّتي أفادها المحقّق الخراساني(قدس سره).
أقول: والذي ينبغي أن يقال تتميماً وتوضيحاً لما حقّقه المحقّق الخراساني(قدس سره) (في الوجه الثاني والرابع) هو: أنّ روح الحكم ليس إلّا إرادة المولى أو كراهته المطلقة
ص: 77
صدور الفعل عن جميع عباده أو تركه، ويكون المولى متسبّباً للمراد بإنشاء الخطاب المطلق _ الّذي لا يكون مقيّداً بالعلم والجهل _ ولكن لا يريد انبعاث المکلّف منه إلّا في ظرف علمه به، وذلك لا لقصور في ناحية المولى بل لقصور الخطاب لأن ينبعث منه العبد في حال الجهل، ولكن حيث يرى عدم كون هذا الخطاب باعثاً لانبعاثه إلّا في صورة العلم فلابدّ وأن يتوسّل لحصول مراده إلى خطاب آخر مثل إيجاب الاحتياط أو إيجاب العمل على طبق الأمارة.
وهذا الخطاب لا ينشأ إلّا من الإرادة الّتي أُنشأ منها الخطاب الأوّل، فالمولى بكلا الخطابين يكون متسبّباً لحصول مراده. ولا فرق بينهما أصلاً، ففي صورة قيام الأمارة على الوفاق لا يكون حكماً في البين إلّا الحكم الواقعي، وفي صورة قيامها على الخلاف لا يكون هنا حكم أصلاً بل هو حكم صوريّ ظاهريّ.
فإذا نظرنا إلى الخطاب الأوّل وأنّه لا يمكن أن يكون باعثاً للمكلّف نحو المراد ولا يريد المولى انبعاث عبده عنه _ مع كون إرادته مطلقة _ إلّا في ظرف علمه به لقصور الخطاب عن البعث والتحريك في غير هذا الظرف، نقول: إنّ الحكم الواقعي إذا قامت الأمارة على الخلاف شأني.
وإذا نظرنا إلى الإرادة الّتي تكون علّةً لإنشاء الخطابين وأنّ المولى أراد صدور الفعل من المکلّف مطلقاً وأنّ دائرة إرادته تكون أوسع ممّا تكون الخطابات الأوّلية باعثة إليه، نقول: إنّ الحكم الواقعي فعليّ.
فيوجّه بهذا کلا الوجهين (الوجه الثاني والرابع)، إلّا أنّ الوجه الرابع هو الأقرب.
وحاصل هذا الوجه: أنّ الحكم الواقعي يكون فعلياً في صورة علم المكلّف به أو قيام الأمارة عليه، ولا يكون حكماً في البين إلّا الحكم الواقعي الفعلي. وفي صورة الأمارة يكون الحكم الواقعي شأنياً، والحكم الظاهريّ صوريّاً محضاً.
ص: 78
هذا کلّه بناءً على كون الأحكام الظاهرية طريقية صرفة، كما هو الحقّ، وقد مرّ عدم صحّة القول بالموضوعية.((1))
الأوّل: مرادنا من فعلية الحكم الواقعي فعليته في صورة إصابة العلم، أو الأمارة القائمة عليه. وأمّا في صورة المخالفة فلا فعلية له، بل هو باقٍ على شأنيته كما لا يخفى.
الثاني: إعلم: أنّ المناط لاستحقاق العقاب وصحّة احتجاج المولى على العبد في صورة المخالفة، واحتجاجه على المولى في صورة عدم إصابة الأمارة ووقوعه في مخالفة الواقع، هو: أمر المولى. كما لو أمره باتّباع الأمارة أو الأخذ بالحالة السابقة أو بأحد طرفي الاحتمال؛ فإنّ لازم هذا الأمر تنجّز الواقع واستحقاق العقاب على المخالفة في صورة الإصابة، ومعذوريته في صورة الخطأ إن قلنا بأنّ معذورية المکلّف في صورة الخطأ من آثار الأمر باتّباع الأمارة، ولم نقل باستناد معذوريته بجهله بالحكم الواقعي _ كما قوّيناه في مبحث القطع _ دون الأمارة.
وهذا، أي تنجّز الواقع واستحقاق العقاب على المخالفة في صورة الإصابة، هو معنى حجّية الأمارة أو الاحتياط أو غيرهما.
وأمّا ما أفاد المحقّق الخراساني(قدس سره) من كون المناط: جعل الحجّية الّتي تكون من آثارها استحقاق العقاب على المخالفة في صورة الإصابة، وتنجّز التكليف ومعذوريته في صورة الخطأ.((2))
ففيه: أنّ معنى الحجّية إن كان تنجّز الواقع واستحقاق العقاب على المخالفة
ص: 79
والمعذورية، فلا يكون هذا من الاُمور الجعلية والاعتبارية. وإن كان معناها شيئاً آخر _ يكون تنجّز الواقع واستحقاق العقاب على المخالفة في صورة الإصابة، والمعذورية في صورة عدمها أثره _ فنحن لا نتعقّل هذا المعنى.
ولا يخفى: أنّه لا فرق بين الحجّية _ في عدم كونها قابلة للجعل _ وغيرها من العناوين المذكورة في کلّمات بعض المعاصرين((1)) كالطريقية والمحرزية والوسطية في الإثبات.
هذا مضافاً إلى أنّ جعل الحجّية، والوسطية أو الطريقية أو المحرزية منافٍ لما هو التحقيق من كون حجّية الأمارات والاُصول إمضائية وعدم كونها تأسيساً واقتراحاً من الشارع، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد توضيح لذلك.
الثالث: لا يخفى عليك: أنّ ما ذكرناه في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي، إنّما يجري فيما إذا كان مؤدّى الأمارة والحكم الظاهري وجوب فعل مع كونه حراماً في الواقع، أو العكس.
وبعبارة اُخرى: ما ذكرناه إنّما يجري إذا أدّى الطريق أو الأصل إلى حكم في قبال الواقع مخالف له، كوجوب فعل مع كونه محكوماً بحكم آخر.
وأمّا إذا كان الحكم الظاهري دالّا على توسعة موضوع الحكم الواقعي، وراجعاً إلى كيفيّة دخل جزء أو شرط في المأمور به وتوضيحه، كالأمارات والاُصول الجارية في الشكّ في أجزاء الصلاة أو شرائطها في الشبهة الموضوعية، مثل قوله: «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر»،((2)) فلا يتأتّى فيه ما ذكرنا من وجه الجمع والتوفيق، ولاحاجة إليه. ووجهه: أنّ
ص: 80
مثل قوله: «كلّ شيء... إلخ» يدلّ على توسعة موضوع الحكم الواقعي _ وهو الصلاة مثلاً _ في ظرف الشكّ، وفردية الصلاة مع الطهارة المشكوكة للصلاة المأمور بها، وانطباقها عليها، من غير تفاوت بينها وبين الصلاة مع الطهارة الحقيقية. ولذا اخترنا في مبحث الإجزاء، إجزاء هذه الصلاة عن الواقع، وقلنا بأنّ منشأ توهم عدم الإجزاء ليس إلّا توهّم كون هذه الصلاة مع الطهارة المشكوكة وفي حال الشكّ في طهارة البدن أو اللباس متعلّقاً لأمر خاصّ غير الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة، والحال أنّه ليس في البين إلّا أمر واحد وهو الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة الّتي أحد أفرادها الصلاة مع الطهارة الواقعية، وأحدها الصلاة مع الطهارة المشكوكة، كما أنّ أحد أفرادها الصلاة مع الطهارة المائية في حال الاختيار وأحدها الصلاة مع الطهارة الترابية في حال الاضطرار، كما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...﴾ الآية،((1)) فما هو المأمور به في حال الاضطرار وفي حال الشكّ هو المأمور به في ظرف الاختيار وفي ظرف العلم، إلّا أنّ مصداق طبيعة الصلاة في حال الاختيار الصلاة مع الطهارة المائية، وفي ظرف الاضطرار مع الطهارة الترابية، وفي حال الشكّ مع الطهارة المستصحبة مثلاً. فتوهّم وجود أمر آخر في البين غير الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة، ليس في محلّه.
وقلنا هناك أيضاً: إنّ ما وقع محلّا للنزاع في مبحث الإجزاء ليس إلّا فيما إذا كان للشارع أمر متعلّق بطبيعة كان لها فرد بحسب حال وفرد بحسب حال آخر، كالاختيار والاضطرار، أو العلم والجهل بوجود الشرط أو الجزء، وأنّ الإتيان بأحد الفردين في حال يجزي عن الإتيان بما هو فردها في حالة اُخرى أم لا؟ وإلّا فلو قلنا بتعلّق أمر مستقلّ بكل واحد من الفردين، فلا يعقل القول بالإجزاء؛ فإنّه لا ريب في عدم إجزاء
ص: 81
الإتيان بما هو مأمور به بأمر عمّا هو المأمور به بأمر آخر، ويصير من قبيل الصلاة والصوم في عدم إجزاء کلّ واحد منهما عن الآخر.
وبالجملة: أدلّة الاُصول والأمارات الجارية في الشكّ في أجزاء الصلاة أو شرائطها حاكمة على الأحكام الواقعية، لكن ليس هنا أمران ظاهري وواقعي، بل أمر واحد تعلّق بالواقعي.
إن قلت: إنّ معنى الحكومة هو كون دليل الحاكم مفسّراً لدليل المحكوم إمّا بتضيق دائرته بلسان التخصيص وإفادة عدم شمول الحكم لجميع الأفراد ورفع حكم الخاصّ الّذي يكون ملاكه مع ملاك الأحكام المتعلقة بسائر أفراد العامّ واحداً، أو بلسان التقييد وإفادة عدم كون الطبيعة المذكورة في دليل المحكوم تمام الموضوع للحكم.
وإمّا موسّعاً لها بإدخال ما كان خارجاً عنه. ولازم ذلك كون دليل الحاكم في عرض دليل المحكوم وفي مرتبته، مثل قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا شكّ لكثير الشكّ»((1)) الحاكم على أدلّة سائر الشکوك. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لتأخّر دليل الحكم الظاهري _ كدليل الأصل مثلاً _ عن دليل اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعية بمرتبتين إحداهما الشكّ في الطهارة المأخوذة في موضوع الحكم الواقعي وثانيتهما أخذ الطهارة في موضوع الحكم الواقعي، ولازم ذلك تعدّد الحكمين وعدم الإجزاء؛ فإنّ الحكم الواقعي باقٍ على حاله، والحكم الظاهري بعد انكشاف الخلاف يزول بزوال موضوعه، فلا وجه للإجزاء.
قلت: نعم، وإن كان دليل الحكم الظاهريّ ودليل الحكم الواقعي ليسا في مرتبة
ص: 82
واحدة، ولكن بعد اتّفاق الكلّ على ورود دليل الأصل وتسليم ظهوره اللفظي فى جعل الحكم الظاهري، وعدم كون دليل الحكم الظاهري مخصِّصاً أو مقيِّداً بالمعنى المصطلح، يبقى الكلام في تقديم ظهور دليل الواقعي وظهور دليل الظاهري، والمدّعى هو تقديم الثاني على الأوّل، وإلّا يلزم لغوية الجعل في صورة الشكّ.
إن قلت: يكفي في عدم اللغوية كونه محكوماً بإتيان الصلاة ما لم ينكشف الخلاف، بل يمكن القول باستفادة ذلك من نفس أدلّة الأحكام الظاهرية لكونها مغيّاة بعدم كشف الخلاف؛ فإنّ قوله: «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر»((1)) مثلاً، بغايته يدلّ على امتداد هذا الحكم إلى زمان العلم، لا مطلقاً.
قلت: أوّلاً: الغاية مسوقة لبيان عدم العلم بالواقع والشكّ فيه، ودخالة الشكّ في موضوع الحكم، لا لبيان عدم وجود حكم المغيّى بعد كشف الخلاف.
وثانيا: العلم بالقذارة مثلاً بعد الشكّ فيها يكشف عن فقدان الطهارة في الصلاة مثلاً، لا عن عدم ترتّب الأثر _ أعني انطباق عنوان المأمور به على المأتيّ به _ وعدم إتيان المکلّف بالصلاة المأمور بها؛ فإنّ المفروض انطباقه ظرف الشكّ ومن جملتها انطباق عنوان المأمور به المشروط بالطهارة عليه، وبعد ترتّب ذلك الأثر لا مجال لارتفاعه.
إن قلت: هذا إذا لم نقل في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بمقالة المحقّق الخراساني(قدس سره) في الكفاية من جعل الحجّية والعذرية،((2)) وإلّا فلا مجال إلّا للقول بعدم الإجزاء.
ص: 83
قبل العلم. فكشف الخلاف لا يوجب رفع ذلك الأثر بعد تسليم ظهور دليل الحكم الظاهري في توسعة الواقع، وأنّه ظاهر في ترتّب جميع آثار الطهارة مثلاً في
قلت: أمّا جعل الحجّية فلا يمكن تصحيحه في المقام، لأنّ الفرض أنّ الحكم المتعلّق بالصلاة المرکّبة من الأجزاء والشرائط الكذائية معلوم للمكلّف، فلا معنى لجعل الحجّية وتنجّز التكليف في صورة موافقة الحكم الظاهري مع الواقعي. وأمّا العذرية فهي بالنسبة إلى الاُصول في بعض الموارد غير مستندة إلى الأصل، وإنّما تكون مستندة إلى الجهل، وفي بعض الموارد لا يمكن فرضه أصلاً، كما لو أتى المکلّف بالصلاة مع اللباس المشكوك في أوّل الوقت إستناداً إلى الأصل فبان عدم كونه طاهراً واقعاً في الوقت، فإنّه لا مجال لعذرية الأصل في مثله.
هذا مضافاً إلى أنّ جعل الشارع حكماً يوجب مخالفة الواقع، في غاية البعد. ومضافاً إلى خصوص الروايات الواردة في المقام، وعدم إمكان الالتزام بتحقّق العذر فقط دون تحقّق المأمور به، كما عن علي(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «إني لا اُبالي أبَوْلٌ أصابني أم ماءٌ إذا لم أعلم»((1))، فإنّ الالتزام بأنّه(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ترك الصلاة أصلاً وكان معذوراً في تركها، بعيد جدّاً.
إن قلت: إنّ الإجزاء منافٍ لجعل الأحكام الظاهرية على نحو الطريقية؛ لأنّ مقتض_ى طريقية الحكم الظاهري عدم الحكم واقعاً في صورة الخطأ.
قلت: إنّا وإن لم نقل بكون الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد الّتي تكون فيها، ولكن لا مانع من كون المصلحة في تحقّق الإطاعة بما هي إطاعة بالنسبة إلى العمل الّذي عيّنه الشارع من بين الأعمال بعد ملاحظة المرجّحات، ومع ذلك لا منافاة بين الإجزاء وطريقية الأحكام الظاهرية، لحصول المصلحة على کلّ حال.
والحاصل: أنّ بعد الفراغ من عدم كون دليل الحكم الظاهري مخصّصاً أو مقيّداً بالمعنى المصطلح، يبقى الكلام في تقديم دليل الحكم الظاهري أو الواقعي، وحيث إنّ
ص: 84
دليل الحكم الظاهري إنّما دلّ على توسعة موضوع الحكم الواقعي، وحكم بكون البدن واللباس المشكوك طهارته مثلاً بحكم الطاهر، فلابدّ حينئذٍ من أحد المعنيين: فإمّا يكون المراد كون المصلّي كذلك معذوراً في المخالفة إذا خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعي، ومستحقّاً للعقاب والتوبيخ من قبل المولى إذا تركها في صورة الإصابة. أو أنّ العمل الكذائي ينطبق عليه عنوان الصلاة. والأوّل غير معقول؛ إذ في صورة كشف الخلاف في الوقت لا مخالفة أصلاً فلا معنى للعذر، و لا عذر في خارج الوقت فلأنّ جعل العذر متفرّع على استناد مخالفة الواقع إلى الجهل وشبهه حتى يكون جعل العذر للامتنان والتسهيل موجَّهاً، وأمّا هنا فتكون المخالفة مستندة إلى نفس هذا الحكم والجعل، فكيف يصحّ أن يكون نفس هذا الجعل الموجب للمخالفة جعلاً للعذر في صورة المخالفة؟
إن قلت: فما وجه الجمع هنا بين الحكم الظاهري والواقعي؟
قلت: لا يمكن التوفيق بينهما بأحد الوجهين المتقدمين.
أمّا كون الحكم الواقعيّ شأنياً والظاهريّ فعلياً؛ فلأنّ الشأنية هناك((1)) حيث تكون متوقّفة على عدم إمكان انبعاث العبد بالخطاب الأوّل في ظرف الشكّ تكون الإرادة الأوّلية المنكشفة بالخطاب الثاني شأنية في صورة عدم الإصابة لا محالة، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لتعيّن الأمر والمأموربه وتمكّن المأمور من تحصيل شرائطه الواقعية، وحكم العقل بلزوم تحصيلها لولا حكم الشارع بتوسعة الموضوع وجعل الحكم الظاهري.
وأمّا الوجه الثاني وهو كون الحكم الظاهريّ حجّة وعذراً وحكماً صوريّاً والواقعي حقيقيّاً، فلما مرّ من عدم تحقّق الحجّية والعذرية هنا من غير فرق بين انكشاف الخلاف في الوقت وخارجه.
ص: 85
ولكن يمكن أن نلتزم بشأنية الواقع وعدم حكم فعلي للشارع غير الشأنية المصطلحة، فإنّها كما ذكرنا لا تدفع الإشكال.
وتقريبه: أنّه لا ريب في أنّ الأحكام لابدّ لها من ملاكات ومصالح وأنّ العبد في مقام الامتثال يقع في الكلفة والمشقّة، ولا تعارض المشقّة والكلفة اللازمة _ الّتي يقتضيها طبع الحكم والإتيان بنفس الطبيعة _ المصلحة الثابتة في متعلّق الحكم، بخلاف المشقّة الزائدة على هذه المشقة، كالمشقة الحاصلة من إتيان نفس الطبيعة وغيرها مقدّمة لها، فإنّه يمكن معارضة المشقّة الزائدة للمصلحة الّتي تكون في متعلّق الحكم، فترفع اليد عن هذه المصلحة لمعارضتها مع هذه المشقّة الزائدة، لئلّا يقع المكلف فيها.
والحاصل: أنّ المستفاد من أدلّة الأحكام الظاهرية أنّ الشارع لا يرضى بتحمّل المشقّة زائداً على الكلفة الّتي اقتضاها نفس الإتيان بالمأمور به، ورَفَع اليد عن اشتراط الشرائط والأجزاء الواقعية في ظرف الشكّ، فيكون العلم بالنجاسة مضرّاً لا أنّ العلم بعدمها شرط.
إن قلت: إذا كان الحكم الواقعي في هذه الموارد شأنياً _ بالمعنى المذكور _ والحكم الظاهري فعلياً، فلا معنى لجعل الحكم الواقعي وجعل الش_رط إبتداءً وواقعاً الطهارة الواقعية، وأعمّ منها ومن الظاهرية ظاهراً وثانياً، وتنزيل المشكوك منزلة المعلوم، فلا ينبغي حينئذٍ إلّا جعل الشرط أعمّ منهما واقعاً حتى يرجع إلى كون الشرط عدم العلم بالنجاسة.
قلت: من الممكن أن يكون الوصول إلى مصالح متعلّقات الأحكام غير مترتّب على وجود المتعلّق بجميع خصوصياته ومشخّصاته في الخارج، وكان مترتّباً على شيء آخر هو حقيقة موضوع الأمر الواقعي وروحه مثل: عنوان الإطاعة أو الخضوع أو الخشوع وإظهار العبودية لله عزّ وجلّ، وكانت الخصوصيات والمشخّصات الموجبة لاختلاف
ص: 86
صور العبادات كالأجزاء والشرائط من قبيل المشخّصات الفردية الخارجة عن حقيقة الطبيعة، إلّا أنّ تعلّق الأمر بهذه الخصوصيات والصور الخاصّة والهيئات المخصوصة وتعيّنها لمكان وجود مصلحة مقتضية مؤثّرة في ذلك ما لم تزاحمها مصلحة أقوى كمصلحة التسهيل أو دفع المشقّة الزائدة، فهذه المصلحة إنّما توجب تعيّن تلك الخصوصيات ما لم توجب هذه الخصوصيات کلفة زائدة على المکلّف. فعلى هذا، لابدّ من جعل الشرط واقعاً وابتداءً الطهارة الواقعية، وأعمّ منها ومن الظاهرية في ظرف الشكّ مثلاً. وهذا يكفي في مقام تصوير إمكان جعل الحكمَين ولو لم يكن في عالم الإثبات دليل في البين، فتدبّر جيّداً.
استشكل بعض الأعاظم من المعاصرين _ كما في تقريرات بحثه _ على مختار المحقّق الخراساني(قدس سره) في الكفاية في مبحث الإجزاء من إجزاء الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية إذا كان دليله أحد الاُصول الجارية في الشبهات الموضوعية لكون دليله حاكماً على دليل الاشتراط ومبيّناً لدائرة الش_رط وأنّه أعمّ من الطهارة الظاهرية والواقعية.((1))
أوّلاً: بعدم استقامة ما أفاده على مسلكه من تفسير الحكومة من كون أحد الدليلين مفسّراً للدليل الآخر على وجه يكون بمنزلة کلمة «أعني» و«أردت» و«أي» وأشباهها من أدوات التفسير، لوضوح أنّ قوله: «كلّ شيء طاهر» أو «حلال» ليس مفسّ_راً لما دلّ على أنّ «الماء طاهر» و«الغنم حلال»، ولا لما دلّ على أنّه يعتبر الوضوء بالماء المطلق الطاهر، والصلاة مع اللباس الطاهر المباح، وأمثال ذلك.
وثانياً: التوسعة والحكومة إنّما تستقيم إذا كانت الطهارة أو الحلّية الظاهرية مجعولة
ص: 87
أوّلاً، ثم يأتي دليل على أنّ ما هو الش_رط في الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية، حتى يكون هذا الدليل موسّعاً وحاكماً على أدلّة اعتبار الطهارة الواقعية، مع أنّ المفروض عدم وجود دليل سوى نفس دليل قاعدة الطهارة وهو قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «كلّ شيء طاهر»، وهو لا يمكن أن يكون معمِّماً أيضاً.
وثالثاً: الحكومة المتصوّرة في باب الطرق والأمارات والاُصول غير الحكومة الموجبة للتوسعة أو التضييق؛ فإنّ الحكومة الموجبة للتوسعة والتضييق إنّما تكون فيما إذا كان دليل الحاكم في مرتبة دليل المحكوم، ولا يكون الشكّ في المحكوم مأخوذاً في دليل الحاكم، وهي لا تتحقّق إلّا بالنسبة إلى أدلّة الأحكام الواقعية بعضها مع بعض، كقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا شكّ لكثير الشكّ»((1)) الحاكم على قوله: «إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع».((2))
وبعبارة اُخرى، نقول: إنّ الحكمين اللذين يتكفّلهما الدليل الحاكم والدليل المحكوم في الأدلّة الواقعية إنّما يكون أحدهما موسّعاً أو مضيّقاً لموضوع الآخر لأجل كونهما مجعولين في عرضٍ واحدٍ؛ فإنّ الحكومة بمنزلة التخصيص، والحكم الخاصّ إنّما يكون مجعولاً واقعاً في عرض جعل الحكم العامّ من دون أن يكون بينهما ترتّب وطولية، فكان هناك حكم مجعول على كثير الشكّ، وحكم آخر مجعول على غيره، وإنّما يسمّى ذلك بالحكومة لا التخصيص لعدم ملاحظة النسبة بين الدليلين، وإلّا فنتيجة الحكومة التخصيص.
وأمّا الحكمان اللذان يتكفّلهما دليل الحكم الظاهري ودليل الحكم الواقعي،
ص: 88
فأحدهما _ وهو الّذي يتكفّله دليل الحكم الظاهري _ مجعول في طول الحكم الواقعي وفي المرتبة المتأخّرة عنه، لأنّ الشكّ مأخوذ في موضوعه.
وبعبارة ثالثة: المجعول الظاهري إنّما هو واقعٌ في رتبة إحراز الواقع والبناء العمليّ عليه بعد جعل الواقع وانحفاظه على ما هو عليه من التوسعة والتضييق، فلا يمكن أن يكون المجعول الظاهري موسّعاً أو مضيقاً للمجعول الواقعي مع عدم كونه في رتبته.
فبناءً على هذا، لا تكون حكومة الحكم الظاهري على الواقعي إلّا في مقام الظاهر والإحراز، ولذا نسمّيه بالحكومة الظاهرية في مقابل الحكومة الواقعية، وهي القسم الأوّل. فيجوز ترتّب آثار الواقع عليه ما لم ينكشف الخلاف، وأمّا بعد كشف الخلاف فينكشف عدم وجدان المأتيّ به لشرطه، ومقتضى القاعدة عدم إجزائه عن الواقع.
وبالجملة: بعد انقسام الحكومة إلى قسمين ظاهرية وواقعية، يتوقف الإجزاء على كون الحكومة في المقام واقعية مع أنّها مستحيلة لأجل أخذ الشكّ في موضوع أدلّة الأصل، ولا ريب أنّ هذا يكون من الحكومة الظاهرية وهي غير مستلزمة للإجزاء.
ورابعاً: اختصاص الاُصول دون الأمارات بذلك تخصيص بلا مخصّص، بل الأمارة أولى من الاُصول بالحكومة المدّعاة في المقام وإجزائها عن الواقع، فإنّ الموجود في الأمارة جعل المحرز للواقع، وفي الأصل ليس إلّا فرض المحرز وجعل آثار المحرز عند الشكّ لا جعل نفس المحرز.
وخامساً: لو كانت الحكومة كما ادّعاه المحقّق المذكور واقعيّة، وقلنا بأنّ الطهارة المجعولة لقاعدة الطهارة واستصحابها موسّعة للطهارة الواقعية، فلابدّ من ترتّب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية، والحكم بطهارة ملاقي مستصحب الطهارة وعدم القول بنجاسته بعد انكشاف الخلاف والعلم بنجاسة الملاقى (بالفتح)، لأنّ الملاقي
ص: 89
حين الملاقاة كان طاهراً بمقتضى التوسعة المستفادة من القاعدة أو الاستصحاب، مع أنّه ممّا لم يلتزم به أحد.((1))
هذا، ولكن لا يذهب عليك ضعف ما أفاده المعاصر المذكور(قدس سره)، فإنّ المناقشة في عدم تحقّق الحكومة في المقام على مختار المحقّق الخراساني(قدس سره) مناقشة لفظية؛ لأنّ المقصود تقدّم دليل الأصل على دليل الاشتراط، وأنّه مبيّن لدائرة الش_رط بأنّه أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية، وأنّ مقتضى ملاحظة قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «كلّ شيء طاهر... إلخ» مع أدلّة اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعية كون الش_رط في حال الشكّ أعمّ من الطهارة الظاهرية والواقعية، سواء استمرّ الشكّ أو لا. ولا دخالة لكون ذلك حكومة على اصطلاح وعدم كونه كذلك على اصطلاحه.
والحاصل: أنّ الإشكال متوجّه إلى المحقّق المذكور من حيث اعتباره في الحكومة كون الدليل الحاكم مفسراً للدليل المحكوم ومصدّراً بأدوات التفسير، لأنّه يكفي في الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى المحكوم بحيث لو لم يكن المحكوم لكان لغواً، سواء كان موسّعاً لدائرة المحكوم بإدخال ما يكون خارجاً عنه أو مضيّقاً له بإخراج ما يكون داخلاً فيه.
مضافاً إلى أنّه ربما لا يوجد دليل يكون مفس_ّراً لدليل آخر ومصدّراً بأدوات التفسير، إلّا أنّ هذا الإشكال لا يكون وارداً على ما اختاره في المقام من تقديم دليل الأصل على أدلّة الاشتراط، وأنّه يستظهر من ملاحظتهما معاً أعمّية الش_رط في حال الشكّ، كما لا يخفى.
وأمّا ما أفاده في الإيراد الثاني، فهو أيضاً مؤاخذة للمحقّق المذكور بظاهر عبارته،
ص: 90
والحال أنّ مراده أنّ مقتض_ى الاستظهار من قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «كلّ شيء طاهر...» ودليل الاشتراط أنّ ما هو الشرط أعمّ من الواقعيّ والظاهريّ.
وبعبارة اُخرى: فردية الصلاة مع الطهارة المشكوكة للصلاة الواقعة تحت الأمر ومصداقيتها لها في حال الشكّ، كفردية الصلاة مع الطهارة الواقعية لها. ومعنى ذلك أنّ القاعدة ناظرة إلى نفس دليل الصلاة وموسّعة لدائرة العنوان المترقّب حصوله وانطباقه على المأتيّ به، فالحكم بالطهارة الظاهرية معناه الحكم بتحقّق العنوان المترقّب انطباقه على الفعل، وحصول ذلك العنوان في ظرف الشكّ، وبعد تحقّق ذلك العنوان والحكم بكون المأتيّ به فرداً له لا معنى لانكشاف الخلاف.
وأمّا إيراده الثالث، ففيه: مضافاً إلى أنّه لا معنى لتقسيم الحكومة إلى الظاهرية والواقعية، ما يظهر ممّا ذكرناه في التذنيب الثالث، فإنّ دليل الأصل ودليل الحكم الواقعي وإن لم يكونا في عرض واحد، ولكن بعد اتّفاق الكلّ على ورود دليل الأصل وجعل الحكم الظاهري في مورد الشكّ وعدم كونه مخصّصاً أو مقيّداً بالمعنى المصطلح، يجب الجمع بينه وبين دليل الحكم الواقعي بتقديم ظهور أحدهما، وحيث إنّ جعل الحكم الظاهريّ الدالّ على توسعة موضوع الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون جعلاً للحجّية والعذرية كما مرّ تفصيله، فلابدّ من القول بكون الصلاة المأتيّ بها كذلك فرداً لطبيعة الصلاة المأمور بها، وأنّ الش_رط أعمّ من الطهارة الظاهرية والواقعية، فتدبّر.
وأمّا الإيراد الرابع، فهو وإن كان وارداً على ما سلكه المحقّق الخراساني(قدس سره) وذهابه إلى التفصيل بين الاُصول والأمارات، ولكن يدفعه ما اخترناه من عدم الفرق بينهما في الإجزاء.((1))
ص: 91
وأمّا إيراده الخامس، فمدفوع بأنّ انطباق الصلاة على الفرد المأتيّ به مع الطهارة الظاهرية في حال الشكّ بمقتضى قاعدة الطهارة لا يقتضي ترتب جميع آثار الواقع حتى بعد العلم وانكشاف الخلاف، فتدبّر جيّداً.
إعلم: أنّ بعد إثبات إمكان التعبّد بغير العلم، ودفع الشبهات المتصوّرة في المقام، وبيان الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعي، يقع الكلام في وقوعه في الأحكام الش_رعية وعدمه، ولابدّ قبل الورود في المطلب من تأسيس الأصل حتى يكون هو المعوّل عليه عند الشكّ وفقد الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم، فنقول:
احتجّ الشيخ(قدس سره) على حرمة التعبّد والاستناد قولاً أو عملاً بالظن الّذي لم يقم على التعبّد به دليل بالأدلّة الأربعة.
قال: ويكفي من الكتاب قوله تعالى: ﴿قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴾((1)) دلّ على أنّ ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشرع فهو افتراء.
ص: 92
ومن السنّة قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في عداد القضاة من أهل النار: «وَرَجُلٌ قَض_ى بِالْ_حَقِّ وَهُوَ لَا يَعْلَم».((1))
ومن الإجماع ما ادّعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيّاً عند العوام، فضلاً عن العلماء.
ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان عن جهل مع التقصير.
نعم، قد يتوهّم متوهمٌ أنّ الاحتياط من هذا القبيل، وهو غلط واضح؛ إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنّه منه مع عدم العلم بأنّه منه، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه، وشتّان ما بينهما، لأنّ العقل يستقل بقبح الأوّل وحسن الثاني.
والحاصل: أنّ المحرم هو العمل بغير العلم متعبّداً به متديّناً به.((2)) انتهى کلامه(قدس سره).
وأورد عليه المحقّق الخراساني(قدس سره) بعدم ارتباط حرمة الالتزام بما يؤدّي إليه الظنّ من الأحكام ونسبته إليه تعالى بالمقام؛ لأنّ المقام واقع في حجّية الظنّ وغيره كأحد طرفي الشكّ وعدمها وليس بينها وبين صحّة الالتزام والاستناد ملازمة، فإنّ من الممكن أن يكون الظنّ حجّة مع عدم صحّة الالتزام والاستناد بمؤدّاه بأنّه حكم الله تعالى، كحجّية الظنّ على تقرير الحكومة في حال الانسداد. كما أنّه لا مانع من عدم حجّيته وصحّة الالتزام والاستناد إليه تعالى إذا دلّ عليها دليل.((3))
ص: 93
فالّذي ينبغي أن يقال في مقام تأسيس الأصل: إنّ الآثار المرغوبة من الحجّة، بل ما يكون منشأً لانتزاع الحجّية ككون شيءٍ منجّزاً للواقع فيما أصاب وعذراً فيما أخطأ، لا يتحقّق إلّا في ظرف العلم بالحجّية وإحراز جعله حجّة وطريقاً مثبتاً، وإلّا فمع عدم العلم وعدم اتّصافه بالحجّية فعلاً لا تكاد تترتّب عليه الآثار المرغوبة، بل لا يتّصف بالحجّية لكون هذه الآثار منشأً لانتزاعها. ولو فرض جعله حجّة في الواقع، فالأصل يقتضي عدم حجّية ما شكّ في اعتباره بالخصوص شرعاً ولم يحرز التعبّد به واقعاً.
وليس هذا أصلاً من الاُصول المعروفة، بل المراد عدم كونه حجّة جزماً ووجداناً، لحكم العقل بعدم حجّيته عند الشكّ.
ولا يخفى: أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني(قدس سره) حقّ، ولا اعتناء بما قد استشكل عليه بأنّ دخل العلم بحجّية شيء في حجّيته مستلزم للمحال، للزوم تقدّم الحجّية على العلم بها وتأخّرها عنه.
لأنّه يمكن أن يقال في جوابه: بأنّ الحجّية تكون مثل الإيقاعات كالطلاق والعتاق، فإنّ الطلاق بوجوده الاعتباري الّذي يعتبره جميع العقلاء ويرتّبون عليه الآثار الخاصّة لا يتحقّق إلّا بعد تحقّق شرائطه مع أنّه موجود في ذهن المطلق واعتباره، ويعتبره هو قبل أن يعتبره العقلاء منشأً للآثار الخاصّة، إلّا أنّ العقلاء لا يعتبرونه إلّا بعد إنشائه وتحقّق سائر شرائطه.
فعلى هذا، نقول: وجود الحجّية يكون مقدّماً على العلم بها في اعتبار جاعلها، ولكن ترتّب الآثار واعتبار وجودها عند جميع العقلاء بحيث يعاملون معها معاملة الحجّة موقوف على العلم بها ويكون متأخّراً عنه.
هذا لو قلنا بأنّ الحجّية قابلة للجعل، أمّا لو لم نقل به فالجواب سهلٌ، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله في مبحث حجّية الظواهر.
ص: 94
وقبل الورود في المطلب ينبغي التنبيه على اُمور:
قد ذكرنا عند البحث عمّا هو الموضوع لعلم الاُصول((1)): أنّ جميع أرباب العلوم العقلية والنقلية _ سوى من شذّ من متأخّري الاُصوليّين _ اتّفقوا على أنّ لكلّ علم موضوعاً على حدة؛ وأنّ تمايز العلوم إنّما يكون بتمايز الموضوعات؛ وأنّ موضوع کلّ علمٍ هو الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ولازم ذلك أن يكون موضوع العلم _ كما يكون جهة امتياز مسائل العلم عن مسائل سائر العلوم _ جهة وحدة لمسائله المختلفة أيضاً، لاشتراك جميع المسائل في كونها باحثة عن عوارض هذا الموضوع؛ وأنّه، أي موضوع العلم، يكون مقدّماً في التحصّل على مسائله، لأنّ المسائل إنّما تكون باحثة عن عوارض هذا الموضوع، فالمعلوم الأوّل _ الّذي يجعله مدوّن العلم تجاه عقله لأن يبحث فيما يدوّنه من المسائل عن شؤونه المجهولة _ هو موضوع العلم. ألا ترى أنّ النحويّ يجعل هيئة الكلمة من جهة آخرها تجاه عقله ويبحث عن مصاديقها؛
ص: 95
والصرفيّ يجعل هيئة الكلمة من غير جهة آخرها تجاه عقله؛ والمنطقيّ يجعل تجاه عقله المعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقي، والمعلوم التصورّي الموصل إلى المجهول التصورّي؛ والحكيم يجعل الموجود بما هو موجود تجاه عقله.
ولا يخفى عليك: أنّ مرادهم _ كما ذكرنا _ من العارض ليس ما اصطلح عليه الطبيعيون، وقسّموه إلى المقولات التسع، وقابلوه بالجوهر _ الّذي إذا وجد وجد لا في موضوع _ بخلافه، فإنّه إذا وجد وجد في موضوع. بل المراد منه العارض المصطلح عند المنطقيّ في باب الإيساغوجي الّذي قسّموه إلى الخاصّة والعرض العامّ، وقابلوه بالذاتي المقسّم إلى النوع والجنس والفصل وهو الخارج المحمول، أي الكلّي الخارج عن الشيء مفهوماً المتّحد معه وجوداً، مثل قولهم: الجنس عرضٌ عامٌّ للفصل، والفصل خاصّةٌ غير شاملةٍ للجنس، وكلّ منهما عرضٌ بالنسبة إلى الآخر، وهما ذاتيان للنوع، فالعرض المنطقيّ إضافيٌ، يعني کلّ مفهومٍ يحمل على مفهومٍ آخر ويتّحد معه وجوداً عرضٌ بالنسبة إليه. بخلاف العرض المصطلح عند الطبيعي، فإنّ عرضيته ليست نسبية بل هو عرضٌ دائماً، كما أنّ الجوهر جوهرٌ دائماً.
وقد ذكرنا هناك أيضاً: أنّ الموضوع لعلم الاُصول وما يجعله الاُصولي تجاه عقله هو «الحجة في الفقه». وأنّ ما استشكله المحقّق القمّي(قدس سره) بأنّ لازم كون مرادهم بالأدلّة هو الحجّية _ حتى يكون مرجع كلامهم كون الموضوع حيثية الحجّة في الفقه _ خروج المسائل الباحثة عن حجّية الحجج كخبر الواحد والإجماع والظاهر وغيرها عن مسائل العلم ودخولها في مباديه، إذ الحجّية تكون على هذا مقوِّمةً للموضوع لا من عوارضه.
مردودٌ؛ فإنّ منشأ هذا الإشكال عدم الالتفات إلى ما هو مراد القوم من موضوع العلم ومن عوارضه الذاتية، وتخيّل أنّ موضوع العلم يلزم أن يكون موضوعاً لمحمولات المسائل أيضاً.
ص: 96
وجوابه: أنّه لا منافاة بين كون الحجّة محمولة في المسائل كخبر الواحد والظاهر، وكون البحث في تلك المسائل عن عوارض الحجّة، فإنّ عوارض الحجّة _ الّتي يبحث في مسألة حجّية الظاهر وخبر الواحد مثلاً عن عروضها واتّحادها مع الحجّة في نفس الأمر _ هي خبر الواحد والظاهر والإجماع وغيرها ممّا وقع موضوعاً في المسائل، لا الحجّية حتى يقال بأنّها مقوّمة للموضوع.
بل لنا أن نقول: بأنّ الظاهر أنّ القضايا الباحثة عن حجّية شيء وعدم حجّيته هي المسائل لهذا العلم، ولذا نرى أنّ الشافعي لم يذكر في رسالته الّتي صنّفها في أواخر القرن الثاني وهي أوّل ما صنّف في علم الاُصول (فيما نعلم) غير مسألة حجّية الكتاب والسنّة غير المنسوخين والإجماع وخبر الواحد والقياس والاجتهاد والاستحسان.
والحاصل: بناءً على ما ذكرناه في بداية البحث (والكتاب) مفصّلاً((1)) وأشرنا إليه هنا إجمالاً: لا ريب في كون مسألة حجّية الظواهر من المسائل الاُصولية، فتدبّر.
قد مرّ منّا عند البحث في وضع الألفاظ أنّها على قسمين((2))، أحدهما: ما وضع لأن يستعمل في إيجاد المعنى، والآخر: ما وضع لأن يستعمل في حكايته وإفهامه.
والأوّل منهما، أي الألفاظ الموضوعة لإيجاد المعنى، على نحوين: لأنّه إمّا أن يكون اللفظ فانياً ومندكّاً في المعنى والمعنى مندكّاً في معنى تصوّري آخر، كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات؛ فإنّ أسماء الإشارة وضعت لإيجاد حقيقة الإشارة مندكّةً في المشار إليه. فهاهنا اندكاكان أحدهما: اندكاك «هذا» وغيره في حقيقة الإشارة الّتي
ص: 97
يستعمل اللفظ لإيجادها، والثاني: اندكاك المعنى، أي حقّيقة الإشارة في المشار إليه. ولابدّ في المبهمات _ في تعيّنها خارجاً _ من معيّن، وما به تتعيّن الإشارة هو: وجود المشار إليه، والإشارة إليه إمّا أن تكون بالامتداد الاعتباري كما في «هذا» وإمّا أن تكون بتقدّم الذكر كما في بعض الضمائر، وإمّا أن تكون بالحضور والمخاطبة، كما في بعضها الآخر، وتارة: تكون بالمعهودية كقولنا: «جاء الّذي ضربناه».
وحيث إنّ الألفاظ المذكورة تكون مندكّةً في معانيها المتصوّرة مستقلّةً، فإذا كانت معهودية في البين فهي الجهة المعيّنة. ولو لم تكن جهةٌ معيّنةٌ في البين، فلابدّ من القول بالتعميم ليحصل بذلك التعيّن في جميع أفراده، كقوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «رفع عن أُمّتي تسعة، ومنها ما لا يعلمون».((1))
وإمّا أن لا يكون اللفظ كذلك أي ليس له هذا الفناء والاندكاك، وهو ما وضع لإيجاد المعاني الاعتبارية، كقولنا: «بعت» و«أنكحت» و«أعتقت» و«إضرب» لإنشاء البيع والنكاح والعتق وطلب الضرب وغيرها من المعاني الّتي ليس لها ما بحذاء في الخارج وإنّما تنتزع من جعل الجاعل وإنشائه. ومثل الحروف الّتي وضعت لأن يشار بها إلى ربط بين المرتبطين مندكّةً فيهما، كما في مثل: «سرت من البص_رة إلى الكوفة»، فكلمة «من» تكون موضوعة لمعنى لا نفسية له. والاستقلال والنفسية إنّما يكون للمرتبطين بسبب تصوّر السير مستقلّا متخصّصاً بخصوصية كون أوّله من البص_رة وآخره الكوفة، وتصوّر زيد متخصّصاً بخصوصية صدور السير الكذائي منه.
وليس بحذاء «من» _ منفرداً _ شيءٌ، وإنّما يحصل منه المعنى حين التركّب. ولذا لو
ص: 98
قال قائل: السير، الصدور، زيد، الابتداء، البصرة، الانتهاء، الكوفة، يتصوّر من کلّ منها معنى بعضها جوهر وبعضها عرض وبعضها ارتباطات بالحمل الذاتي، من غير أن يفهم ارتباط بعضها مع بعض بنحو من أنحاء الارتباط. وأمّا لو قيل: «سار زيد من البصرة إلى الكوفة» فيفهم منه وجود سير مرتبط بزيد بسبب صدوره منه، وبالبص_رة والكوفة بابتدائه من البصرة وانتهائه إلى الكوفة. ففي الأوّل لا يفهم من الكلمات المذكورة إلّا تصوّر معانٍ منفردة، بخلاف الثاني.
قال قائل: السير، الصدور، زيد، الابتداء، البصرة، الانتهاء، الكوفة، يتصوّر من کلّ منها معنى بعضها جوهر وبعضها عرض وبعضها ارتباطات بالحمل الذاتي، من غير أن يفهم ارتباط بعضها مع بعض بنحو من أنحاء الارتباط. وأمّا لو قيل: «سار زيد من البصرة إلى الكوفة» فيفهم منه وجود سير مرتبط بزيد بسبب صدوره منه، وبالبص_رة والكوفة بابتدائه من البصرة وانتهائه إلى الكوفة. ففي الأوّل لا يفهم من الكلمات المذكورة إلّا تصوّر معانٍ منفردة، بخلاف الثاني.
والحاصل: أنّ کلّمة «من» وغيرها من الحروف وضعت لإفادة حقيقة الارتباط، كالابتداء وما هو بالحمل الشائع ابتداءٌ، لا مفهوم الابتداء وما هو الابتداء بالحمل الذاتي. وبعبارة اُخرى: وضعت لإفادة ارتباط شيءٍ بش_يءٍ آخر وكونهما مرتبطين بالحمل الشائع، فلا تکون في الخارج ولا في الذهن إلّا بأن يكون الارتباط مندكّاً فيهما موجوداً بعين وجودهما. وهذا لا يمكن إلّا بأن يكون اللفظ موضوعاً لأن يجعل في الكلام بجنب اللفظين الدالّين على طرفي الارتباط، لا لأن يتصوّر بحذائه ذلك الارتباط حتى يخرج عن كونه ارتباطاً حقيقياً وينتقض الغرض، بل لأن يفهم بسببه ما يفهم من اللفظين من المعنى متخصّصين بخصوصية تكون منشأً لانتزاع ذلك الارتباط منهما إذا نظر العقل إليهما بنظر آخر غير هذا النظر الّذي يكون الارتباط بحسبه ارتباطاً بالحمل الشائع ومندكّاً في الطرفين.
والثاني: على قسمين:
قسمٌ: وضع لإفهام المعاني إفهاماً تصوّرياً، كالألفاظ المفردة، مثل: زيد، وعمرو، وبكر، وأمثال ذلك من الألفاظ الّتي تدلّ على معانيها عند العالم بها ولو سمع من مجنون أو نائم وغيرهما. وممّا وضع لإفادة المعاني التصورّية: أسماء المبهمات كالموصولات، وأسماء الإشارة.
ص: 99
وقسم: وضع لإفهام المعاني التصديقية، والمراد بها المعاني الارتباطية الّتي هي النسب. والمراد من المعنى الارتباطيّ الّذي يدلّ عليه اللفظ كون المعنى بحيث لا يكون له ما بحذاء لا في الخارج ولا في الذهن بل نفس الارتباط الّذي يكون بالحمل الشائع ارتباطاً، لا ما يكون بالحمل الأوّلي الذاتي ارتباطاً، وهذا كالمعاني الحرفية.
إذا عرفت ذلك کلّه، فاعلم: أنّ الألفاظ الموضوعة لإفهام المعاني التصوّرية دلالتها على المعنى لا تتوقّف على إرادة المتکلّم، ولا يحتاج إلى أزيد من كون اللفظ موضوعاً لهذا المعنى التصورّي. وأمّا الألفاظ الموضوعة لإفهام المعاني التصديقية فدلالتها على المعنى تتوقف على مقدمات: إحداها: وضع ألفاظ مفرداتها لمعانيها التصورّية، ووضع هيئاتها التركيبية لإفهام المعنى التصديقي.
ثانيتها: كون المتکلّم عاقلاً.
ثالثتها: كونه مريداً لمعنى اللفظ، وعدم احتمال كونه في مقام إغراء المخاطب بالجهل.
رابعتها: علم المخاطب بعلم المتکلّم بالوضع ومطابقة علمه الواقع.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ إرادة المعاني إنّما تكون من مقدّمات دلالة اللفظ على المعنى التصديقي، وهذا مراد (العلمين)((1)) من أنّ الدلالة تتبع الإرادة، لا ما ذهب إليه المحقّق الخراساني(قدس سره) من كون مرادهما أنّ دلالة الألفاظ على كونها مرادة للافظها تابعة لإرادتها منها.((2))
ص: 100
إنّ اعتناء الإنسان بكلام کلّ متكلّم إمّا أن يكون لأجل تحصيل التصديق بما يعلمه المتکلّم كبعض الاُمور الاعتقادية. فإذا كانت جميع المقدّمات المذكورة قطعية تكون النتيجة أيضاً قطعية. ولو كانت جميعها أو بعضها ظنّية تكون نتيجتها ظنّية. وإن كانت جميعها أو بعضها احتمالية تكون النتيجة احتمالية، وهذا القسم خارج عن محط بحث الاُصولي.
وإمّا أن يكون غرضه تحصيل العلم مقدمةً للعمل.
فلو كان مقصوده من الاعتناء بكلام الغير وفهم مراده حصول العلم بأمر مقدّمةً للعمل به ممّا يكون راجعاً إلى الاُمور الدنيوية من غير أن تكون في البين خصوصيات اُخرى كمولوية المتکلّم واستعلائه على المخاطب وعبودية المخاطب له، كالتاجر الّذي يسأل غيره عن قيمة جنس في بلد يريد حمل متاعه إليه، فالأخذ بظاهر قول المتکلّم والاعتناء بالاحتمالات المتطرّقة فيه وعدمه يدور مدار الاهتمام بشأن سلعته وعدمه، وهذا أيضاً خارج عن محلّ بحث الاُصولي.
وأمّا إن كان غرضه تحصيل العلم بمراد المتکلّم مقدّمةً للعمل به مع كون المتکلّم صاحب مولوية واستعلاء عليه، وكان العمل بقوله واجباً على المخاطب عقلاً كالعبيد بالنسبة إلى المولى الحقيقي، أو عرفاً كالموالي والعبيد العرفيين، وهذا هو الّذي يكون محطّ نظر الاُصولي ومورداً لكلامه دون غيره.
فإذا صدر من المولى کلامٌ ظاهرٌ في معنى من المعاني ولم ينصب على خلافه قرينة ولم يعمل العبد على طبق ظاهر کلامه، فهل له الاحتجاج على العبد ومؤاخذته على ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِِذَ أَمَرْتُكَ﴾،((1)) وهل يجوّز العقل عقوبته إن
ص: 101
أراد المولى معاقبته، كما قال تعالى لإبليس: ﴿اِِهْبِطُوا مِنْهَا جَميعاً﴾((1)) لمّا خالف أمره سبحانه أو لا يصحّ له ذلك؟ وأيضاً هل يكون للعبد إذا عمل على طبق ظاهر کلام المولى واعترض عليه المولى بأنّي ما أردت ظاهر کلامي بل أردت خلافه، الاحتجاج على المولى بأنّك لو أردت خلاف ما هو ظاهر كلامك فلِمَ لم تنصب القرينة عليه أو لا؟
فإذا عرفت ذلك کلّه، فاعلم: أنّ الكلام في مبحث حجّية الظواهر يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في تعيين ظواهر الألفاظ وأنّ لفظ الصعيد مثلاً ظاهر في أيّ معنى من المعاني.
والمقام الثاني: في حجّية الألفاظ الدائرة في ألسنة أهل المحاورة الظاهرة في معانيها المخصوصة.
والكلام على الأوّل يكون صغروياً، وعلى الثاني يكون كبروياً، وما يهمّنا البحث عنه هو المقام الثاني، فنقول وبالله نستعين:
إعلم: أنّ أقدم الأمارات وأشملها وأعمّها ظواهر الألفاظ، فإنّ عليه مدار مدنيّة الإنسان، وعليه تدور رحى اُموره الاجتماعية، فهو من أوّل يوم دخل في الحياة الاجتماعية أحسّ باحتياجه إلى ما به يُفهِم مراده إلى غيره، ويستفهم مراد غيره، ولم يجد شيئاً أسهل وأخفّ مؤونة من الأصوات، فاختارها وسيلة لذلك، حتى صار بعض الألفاظ قالباً لبعض المعاني إمّا من جهة جعله كذلك، أو كثرة استعماله، أو غير ذلك.
ودلالة الألفاظ الظاهرة في معنى من المعاني إذا كانت من الألفاظ المفردة أو المرکّبات غير التامّة لا تحتاج إلى أزيد من التلفّظ بها، كان المتلفّظ بها عاقلاً أم لا، فمجرّد التلفظ بهذه الألفاظ موجِد لتصوّر معانيها وحصولها في ذهن السامع العالم بظهورها في هذه المعاني.
ص: 102
وهذا بخلاف ألفاظ المرکّبات التامّة، فإنّ دلالتها على معانيها التصديقية تتوقّف على أزيد من ذلك، ككون اللافظ عاقلاً حكيماً، وإن كان ارتكاز هذه المقدّمات في أذهان العرف والعقلاء يغني عن عنايتهم بها، ولذا ترى أنّهم يحملون ظواهر کلام المتکلّم الحكيم على معانيها التصورية والتصديقية بمجرّد استماعهم منه.
وممّن يحتاج إلى استعمال الألفاظ وإفادة المعاني واستفادتها بسببه هم الموالي والعبيد؛ فإنّ المولى محتاج في مقام تفهيم مراده إلى العبد باستعمال الألفاظ، والعبد محتاج أيضاً في مقام فهم مراد المولى إلى معرفة ذلك من قبله، ولا يمكن ذلك عادة إلّا بواسطة استعمال الألفاظ وما كان من هذا القبيل كالإشارة، وإن كان غير اللفظ لا يقوم هذا المقام ولا يؤدّي هذه الوظيفة في جميع الموارد، بل لا يمكن الاتّكال عليه عادة إلّا في الموارد الّتي لا يتمكّن المولى من إفهام مراده بتوسّط الألفاظ، فما يكون غير الألفاظ من الوسائط حتى الكتابة لا يكون كاللفظ في إظهار ما في الضمير، ولا يكون مثله مناسباً لوضع الإنسان وحياته الاجتماعية. فاللفظ هو أسهل ما يمكن أن يتمسّك الإنسان به لإظهار مراداته وأشمله. ولولا هذه الألفاظ لاختلّ نظام حياته الاجتماعية.
والحاصل: أنّ حجّية الظواهر إنّما تكون مقصورة بهذا المورد، أي الامور المربوطة بالموالي والعبيد دون غيره، فإنّه يصحّ للمولى أن يحتجّ على عبده إذا خالف ظاهر کلامه، ولا يعدّ العقلاء عقابه لمخالفته هذه ظلماً وقبيحاً. وللعبد أن يحتجّ على المولى إذا وافق ظاهر کلامه، وليس للمولى عقابه لو ارتكب خلاف مراده الواقعي بعد موافقته ظاهر کلامه.
وهذا بخلاف الألفاظ المستعملة بين سائر الناس، فإنّه ليس لأحدهم هذا الاحتجاج على الآخر، وإنّما يعوّلون عليها لمكان احتياجهم إلى إفهام مراداتهم واستفادة مقاصد غيرهم.
ص: 103
وكيف كان، لا إشكال في حجّية ظواهر الألفاظ الدائرة بين الموالي والعبيد إذا كان صادراً من المولى في مقام إعمال المولوية، وحجّيتها غنية عن البيان، وعليها بناء العقلاء.((1))
وحيث إنّ بناء العقلاء هو عمدة ما استدلّ به في باب الظواهر وخبر الواحد، بل جميع ما ذكر من الأدلّة راجع إليه والمباحث المذكورة في الكتب الاُصولية أكثرها إمّا تكون من المبادي، أو ممّا تتفرّع على المباحث المتعلّقة بنفس العلم، ومسألة حجّية الظواهر وحجّية خبر الواحد وما يتفرّع عليها من حجّية الشهرة والإجماع المنقول من أهمّ المسائل الاُصولية ومورد الاحتياج في جلّ مباحث الفقه ولا ينبغي طي هذا الاستدلال وإهماله كما صنع بعض الاُصوليّين، فيجب علينا التكلّم فيه بمقدار يتّضح به المراد، فنقول:
يمكن تقرير هذا الاستدلال بوجهين:
أحدهما: أنّ العقلاء في اُمورهم الاجتماعية من المعاشرات والمعاملات وغيرها استقرّ بناؤهم على اتّباع الظاهر والعمل به، ويستكشف من عدم ردع الشارع عن تلك الطريقة المستمرّة والسيرة المستقرّة جواز العمل بما يقتضيه الظاهر شرعاً.
ثانيهما: أنّ العقلاء في الخطابات الصادرة من الموالي لتحريك العبيد وبعثهم أو زجرهم استقرّت سيرتهم على حجّية ظواهرها ما دام لم يتّخذ المولى طريقة اُخرى في تفهيم مراداته غير الطريقة المتداولة بين سائر الموالي والعبيد.
ومعنى استقرار طريقتهم وبنائهم على الحجّية حكمهم بصحّة مؤاخذة العبد من
ص: 104
جانب المولى إذا خالف ظاهر خطابه، وعدم كونه في عقابه العبد على ذلك ظالماً؛ وعدم صحّة مؤاخذة العبد إذا خالف مراده الواقعي مع موافقته مقتضى ظاهر کلام المولى، وكون عقابه في ذلك الفرض قبيحاً وظلماً.
لا يخفى: أنّ الوجه الثاني هو أمتن الوجهين، إلّا أنّ اللازم أن يعلم مرادهم من بناء العقلاء، وأنّ الاستدلال به يكون الاستدلال بما يقتضي بناء غيرنا من العقلاء، بمعنى أنّ کلّ أحد يرجع في ذلك إلى سائر العقلاء من غير أن يجد من نفسه وعقله هذا، حتى يكون الحدّ الأوسط في البرهان بناء غيره من العقلاء، وكان البرهان ل_مّياً، لأجل كون استقرار طريقتهم علّة لحجّية الظاهر، فيقال في مقام الاستدلال مثلاً: هذا ممّا استقرّت عليه طريقة العقلاء، وكلّ ما استقرّت عليه طريقة العقلاء فهو واقع، فهذا واقع.
أو يكون المراد من بناء العقلاء والاستدلال به حكم العقلاء بصحّة المعاقبة المذكورة واحتجاج المولى على العبد، وقبحها إذا وافق العبد مقتضى ظاهر کلام المولى، حتى يكون مرجع الدليل إلى التحسين والتقبيح العقليّين، بمعنى تقبيح العقل مؤاخذة المولى عبده إذا اتّبع ظاهر كلامه، وتحسينه مؤاخذته إذا خالف ظاهر کلامه. فكلّ واحد من العقلاء إذا راجع إلى عقله يجده حاكماً بقبح مؤاخذة المولى عبده واحتجاجه عليه في الصورة الاُولى، وعدم قبحها في الصورة الثانية.
والحاصل: أنّ معنى التمسّك باستقرار سيرة العقلاء وبنائهم، ليس أنّ کلّ واحد منّا إذا راجع إلى عقله لم يجد منه الحكم بحجّية الظواهر، حتى يتوقّف إثبات حجّيته على استقرار سيرة العقلاء.
بل المراد من هذا الاستدلال: الاستدلال بضرورة العقل، وإطباق جميع العقول على هذا الحكم، وكونه من الضروريات غير المحتاجة إلى إقامة البرهان والدليل.
ص: 105
فعلى هذا، يكون البرهان إنّياً لاستفادة استقرار طريقة العقلاء من حجية الظواهر وحكم العقل بالتقبيح والتحسين المذكورين، فيقال مثلاً: الظاهر ممّا يصحّ به احتجاج المولى على عبده، وكلّ ما يكون كذلك فعليه استقرار طريقة العقلاء، فالاحتجاج بالظاهر ممّا استقرّت عليه سيرة العقلاء.
ثم إنّ الظاهر أنّ ملاك حكم العقل واتّفاق العقلاء على حجّية ظواهر الخطابات الصادرة من الموالي إلى العبيد لتحريكهم أو زجرهم ليس ذات الظاهر حتى يكون باب حجّية الظواهر كباب القطع في كون حجّيته ذاتية، بل ما هو المقتض_ي لذلك في مقام الثبوت وتمام الملاك: ما يرى العقل من احتياج الإنسان في حياته الاجتماعية ونظم اُمور معاشه ومعاده إلى تفهيم مقاصده لغيره، وتفهّم مرادات غيره، مع عدم وجود طريق يكون وافياً لذلك عادة إلّا التلفّظ بالألفاظ والتكلّم، فالعقل مع انسداد الطريق وانحصاره في ظواهر الألفاظ وعدم اتّخاذ المولى طريقة خاصّة لتفهيم مراداته يحكم بحجّية ظاهر کلامه.
وكيف كان، فلا ريب ولا خلاف في حجّية الظواهر الصادرة من الموالي لتحريك العبيد أو زجرهم عند العقلاء، وعليها اتفاق عقولهم.
كما أنّه لا ريب في عدم اعتنائهم باحتمال كون المتکلّم ساهياً أو غافلاً أو لاغياً، أو احتمال إرادة المتکلّم ترتّب غاية اُخرى على فعله غير ما هو غايته بحسب المتعارف؛ وذلك لأنّ بناء العقلاء استقرّ على حمل الفعل الصادر من العاقل المختار على صدوره مع الالتفات، ولأجل ترتّب فائدته عليه.
كما أنّهم لا يعتنون باحتمال احتفاف الكلام بما يوجب صرفه إلى غير معناه الظاهر
ص: 106
فيه، أو بما يوجب طروّ الإجمال، أو احتمال كونه في مقام الإجمال والإهمال مع القطع بعدم وجود القرينة الصارفة.
ولا فائدة في البحث عن رجوع الاُصول الجارية في هذه الموارد إلى الاُصول العدمية كأصالة عدم وجود قرينة دالّة على عدم إرادة المتكلّم المعنى الحقيقي؛ أو إلى الاُصول الوجودية كأصالة الظهور، وهي عبارة عن بنائهم على اتّباع الظاهر عند تطرّق جميع هذه الاحتمالات.
إنّما الخلاف واقع في مقامين:
أحدهما: التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره
ذهب بعض إلى اختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه دون غيره.
ووجهه احتمال أن يكون بين المتکلّم والمقصود بالإفهام قرائن معهودة اتّكل عليها المتکلّم في مقام التخاطب.
ولا فرق في ذلك التفصيل بين كون غير من قصد إفهامه شريكاً مع المقصود بالإفهام في التكليف، وبين عدم كونه كذلك.
وهذا الوجه هو مختار المحقّق القمّي(قدس سره)((1)) ونسب إلى ظاهر كلام صاحب المعالم(قدس سره). وقد بنى عليه حجّية الظنّ المطلق، لأنّه بعد البناء على اختصاص حجّيتها بمن قصد إفهامه مع كون أكثر أدلّة الفقه بل جلّها ظواهر ألفاظ القرآن العظيم والروايات والأحاديث الواردة عن أهله(علیهم السلام) ينسدّ باب العلم والعلمي إلى الأحكام، فنحتاج إلى إجراء دليل الانسداد لإثبات حجّية الظواهر.((2))
ص: 107
وأمّا ما توهّم بعض من أنّ منشأ ذهاب المحقّق القمّي(قدس سره) إلى القول بحجّية الظنّ المطلق هو ضعف سند أكثر الروايات.
فليس في محلّه، لعدم عين ولا أثر من ذلك في کلماته.
ثانيهما: مقالة الأخباريّين
اختار بعض إخواننا الأخبارييّن _ رحمهم الله تعالى _ عدم حجّية ظواهر الكتاب بدون التفسير عنهم(علیهم السلام)((1)) حرصا على التمسّك بالروايات والأخذ بما ورد عنهم عليهم الصلاة والسلام.
وسيأتي في أنّ التمسّك بالكتاب العزيز لا يمنع من التمسّك بالأحاديث المروية عن أهله(علیهم السلام). ولا ينبغي لمسلم أن يرضى لنفسه بجعل الكتاب المبين _ الّذي تقشعرّ منه جلود الّذين يخشون ربهم،((2)) وأنزله الله على عبده ليكون للعالمين نذيراً((3)) _ كتاباً من الكتب الرمزية، مع قيام ضرورة المسلمين واتّفاقهم على خلاف ذلك، ومع كون الروايات الشريفة الدالّة على فساد هذا التوهّم الضعيف أكثر من أن تحصى.
والحاصل: أنّ الخلاف وقع في المقامين المذكورين.
توجيه الشيخ(قدس سره) لتفصيل القمّي(قدس سره)
أمّا الكلام في التفصيل المنسوب إلى المحقّق القمّي(قدس سره)، فنقول: إنّ الشيخ(قدس سره) قد وجّه هذا التفصيل بأنّ الظاهر إنّما يكون حجّة إذا كان الكلام بحيث لو خلّي وطبعه مفيداً للظنّ النوعي بكون المراد ظاهره وما هو قالب له. وأمّا إذا لم يكن كذلك، فلا يكون حجّة عند العقلاء. والكلام الملقى لإرادة الإفهام والإفادة إنّما يكون كذلك _ أي
ص: 108
موجباً للظنّ النوعي _ لمن كان مقصوداً بالإفهام، لأنّه ليس في البين ما يوجب التردّد في حجّيته وكون الظاهر مراده إلّا احتمال غفلة المتکلّم عن نصب قرينة صارفة عمّا يكون اللفظ ظاهراً فيه وقالباً له، واحتمال غفلة المخاطب عن الالتفات إلى ما كان الكلام محفوفاً به من القرينة، ولا اعتناء بهما إمّا لوجود الظنّ بالخلاف أي بعدم الغفلة، أو عدم اعتناء العقلاء باحتمال الغفلة في اُمورهم.
وأمّا إذا كان الشكّ في الحجّية وكون ظاهر اللفظ مراداً للمتكلّم لاحتمالات اُخرى، كاحتمال اختفاء القرينة المنفصلة _ مع نصبها وعدم غفلة المقصود بالإفهام عنها _ عن غير المقصود بالإفهام لجهات موجبة للاختفاء، أو اتّكال المتکلّم على القرائن العقلية والحالية في إفهام من قصد إفهامه، واحتمال اختفاء القرينة المتّصلة بسبب تقطيع الكلام، فلا يكون الظاهر حجّة، لعدم كون الظاهر بحيث لو خلّي وطبعه موجباً للظن النوعي بالمراد، إذ الكلام ليس بحيث يدفع ذلك الاحتمال. فإنّ الواجب على المتکلّم إلقاء الكلام على وجه يفي بإفهام مراده عند من قصد إفهامه، أمّا إلقاء الكلام على نحو لا يفهم مراده منه کلّ من سمع كلامه وحكي له، فلا يكون حجّة له لاحتمال اتّكال المتکلّم في إفهام مراده على القرائن الحالية أو المقالية الّتي اختفت على غير من قصد إفهامه، أو القرائن المتّصله مثل ما قال قبله أو بعده، أو احتمال كون الكلام بحيث لو نقل إلينا من أوّله إلى آخره كان وافياً بمراد المتکلّم ولكن بعروض التقطيع صار ظاهره خلاف مراده.
ولا مجال لدفع هذه الاحتمالات بالتمسّك بأصالة العدم أو أصالة عدم القرينة، لعدم حجّيتها في مثل المقام، لعدم حصول الظنّ بانتفائها في مثل المقام.
اللّهمّ إلّا أن يدّعى كون أصالة عدم القرينة حجّة من باب التعبّد، ودون إثباتها خرط القتاد.((1))
ص: 109
إن قلت: نعم، لا يحصل الظنّ بانتفاء القرينة قبل الفحص عنها، وأمّا بعد الفحص وعدم وجدان القرينة فيحصل الظنّ بأنّ الظاهر هو المراد.
قلت: مضافاً إلى أنّه يمكن منع حصول الظنّ بالمراد، لا دليل على حجّية هذا الظنّ لو سلّمنا حصوله، لعدم كونه مستنداً إلى الكلام وكونه ظنّاً خارجياً حاصلاً من الفحص، ولا دليل على حجّيته بالخصوص.
ولا يخفى عليك: أنّه على هذا التوجيه يكون مقتضى التفصيل في محل ابتلائنا _ وهو ظاهر الكتاب والأخبار _ القول بحجّية کلّ ظاهر مقطوع كونه مراد المتکلّم، وعدم حجّية غيره؛ لأنّ الفرض أنّ من قصد إفهامه لا يشكّ في كون الظاهر مراد المتکلّم إمّا لاحتمال غفلة المتکلّم وهو مقطوع العدم في محلّ الابتلاء، وإمّا لغفلة المخاطب وهو أيضاً مقطوع العدم، لأنّ المخاطب لا يكون غافلاً عن حال نفسه فإمّا يرى نفسه غافلاً فلا يكون الظاهر حجّة بالنسبة إليه، وإمّا لا يرى نفسه غافلاً فيقطع بعدم اختفاء شيء _ ممّا احتفّ بكلام المتکلّم _ عنه.
وكيف كان، فالّذي ينبغي أن يقال جواباً عن هذا التفصيل: عدم ابتناء بناء العقلاء في حجّية الظواهر على جريان أصالة عدم القرينة، بمعنى أنّهم يبنون أوّلاً على عدم وجود القرينة وعدم الغفلة بسبب الأصل، ثم يأخذون بظاهر اللفظ.
بل يتّبعون ظاهر اللفظ ويحتجّون به في موارد الاحتجاج من غير توجّه إلى ذلك، لأنّ بناءَهم استقرّ على أنّ صدور الفعل من الفاعل وهو التكلّم بالإرادة والاختيار لأجل تحصيل غايته الطبيعية الّتي تترتّب عليها وهو في المقام إفهام الغير وإفادة المعنى الّذي يكون اللفظ ظاهراً فيه، وهذا كما ترى ليس متوقّفاً ومبتنياً على إجراء أصالة عدم الغفلة والقرينة.
ص: 110
والحاصل: أنّ التفصيل بين من قصد إفهامه وبين غيره إن كان لمجرّد ذلك، فلا وجه له أصلاً. ألا ترى عدم صحّة اعتذار العبد _ إذا لم يكن مقصوداً بالإفهام ومع ذلك علم أنّ المولى أمره _ : بأنّي لم أكن مقصوداً بالإفهام.
وإن كان لاختلافهما من جهات اُخرى، فإن كان لاحتمال وجود قرينة حالية اتّكل عليها المتکلّم في إفهام مراده؛ فلا فرق في عدم الاعتناء به بين المقصود بالإفهام وغيره، فكما أنّ المقصود بالإفهام يأخذ بظهور اللفظ ولو لم يكن مخاطباً به، يأخذ غيره أيضاً بظهور اللفظ.
وإن كان لاحتمال اتّكاله في إفهام مراده على ما هو الموجود في ذهن من قصد إفهامه؛ فهذا الاحتمال أيضاً ممّا لا اعتناء به عند العقلاء. مضافاً إلى وجود هذا الاحتمال بالنسبة إلى من قصد إفهامه أيضاً، لاحتمال اتّكال المتکلّم على بعض ما في ذهن المقصود بالإفهام.
الفحص عن المخصّص وعدمه _ من غير فرق بين المقصود بالإفهام وبين غيره.
والحاصل: أنّا لم نجد فرقاً بينهما في حجّية الظهور، فهذا التفصيل بظاهره غير متين.
ثم إنّه قد أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين _ كما في تقريرات بحثه _ بأنّا لو سلّمنا ما أفاده المحقّق القمّي(قدس سره) من التفصيل، لكنّه لا تتمّ النتيجة الّتي رتّبها عليه من حجّية مطلق الظنّ، فإنّ الأخبار والروايات بالنسبة إلينا تكون مثل كتب التأليف والتصنيف، لأنّ نقلة الروايات في مبدء السلسلة كانوا هم المخاطبين بالكلام غالباً، وقد اعترف المفصّل بأنّ ظاهر الكلام حجّة في حقّهم، وبعد ذلك اُودعت تلك الروايات في الاُصول ثم في الجوامع والكتب، ولابدّ أن يكون الراوي عن الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)
ص: 111
يودع أو ينقل ما سمعه من الكلام مع کلّ ما احتفّ به من القرائن الحالية والمقالية، لأنّ غرضه من نقله هو إفهام الغير، فتكون الكتب المودّعة فيها الروايات كالكتب المؤلّفة الّتي اعترف بحجّية ظواهرها لكلّ من نظر فيها وقرأها.((1))
وفيه: أنّ المقصود بالإفهام في رواية رواها مثلاً محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ليس إلّا محمد بن مسلم، وأمّا محمد بن مسلم فيحكي ما صدر من الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) وينقل لفظه، ومقصوده إفهام العلاء بأنّ الإمام قال هكذا، لا إفهام مراد الإمام، ومراد العلاء أيضاً في نقله إفهام صفوان أنّ محمد بن مسلم قال هكذا، وهكذا صفوان ومن روى عنه، وليس مرادهم من کلامهم إفهام ما أراد الإمام. فعلى هذا، لا يكون غير محمد بن مسلم _ الّذي هو مخاطب للإمام في المثال _ مقصوداً بالإفهام بالنسبة إلى متن الرواية المنقولة عن الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ). هذا تمام الكلام في التفصيل المنسوب إلى المحقّق القمّي(قدس سره).
وأمّا الخلاف الثاني المنسوب إلى بعض المتأخّرين من المنتحلين للإمامية، فيرجع إلى منع حجّية ظواهر الكتاب بعد ما لم يكن لاحتماله عينٌ ولا أثرٌ عند أحدٍ من المسلمين فضلاً عن العلماء المحقّقين، وذلك لوضوح أنّ الكتاب العزيز إنّما اُنزل لينذر به الكافرين والظالمين ويبشّر به المؤمنين، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ الله شَهِيدٌ بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إلَىَّ هَذَا القُرآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾.((2))
ص: 112
ولا شكّ أنّه بلسانٍ عربيٍ مبينٍ، وأنّه هدىً وبيانٌ وتبيانٌ، ويهدي إلى صراطٍ مستقيمٍ، ويبشّر به المؤمنين، وينذر الكافرين، وتقشعرّ منه الجلود، وأنّ أمر التبليغ والرسالة ما قام عمدها إلّا بوسيلة القرآن وقراءة النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) الآيات المنزلة عليه على الناس، وقد أمر الله تعالى نبيه بإرسال عليّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ليقرأ سورة البراءة على المشركين.((1))
وبالجملة: لا ريب في حجّيته، ولا خلاف فيها بين المسلمين، ولم ينقل الخلاف إلّا عن بعض المنتحلين إلى الإمامية من الأخباريين.
وما يمكن أن يكون وجهاً لهذا التوهّم الفاسد ليس إلّا أحد الوجوه الخمسة المذكورة في الكفاية((2)):
أحدها: دعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به.
وهذا الوجه يمكن أن يكون راجعاً إلى ما ذكره المحقّق القمّي(قدس سره)، فإنّ غير من خوطب به ليس مقصوداً بالإفهام.
ويمكن أن يكون راجعاً إلى:
الوجه الثاني من الوجوه الخمسة المذكورة، وهو: أنّه لأجل احتوائه على مضامين
ص: 113
عالية شامخة غامضة لا تكاد تصل إليها أيدي اُولي الأفكار والأنظار غير الراسخين في العلم، كيف ولا يكاد يصل إلى فهم کلمات الأوائل إلّا الأوحديّ من الأفاضل، فما ظنّك بكلامه تعالى.
ثالثها: دعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتّباعه للظاهر، ولا أقلّ من احتمال شموله لتشابه المتشابه.((1))
رابعها: دعوى أنّه وإن لم يكن منه ذاتاً إلّا أنّه صار منه عرضاً؛ للعلم الإجمالي بطروّ التخصيص والتقييد والتجوّز في غير واحد من ظواهره، كما هو الظاهر.((2))
خامسها: دعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى.((3))
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه مقالة الأخباريّين.
والجواب عن كون احتواء الكتاب على مضامين عالية شامخة موجباً لعدم وصول أيدي اُولي الأفكار والأنظار غير الراسخين في العلم إليها، أوّلاً: أنّ الآيات المتضمّنة لتلك المضامين الشامخة إنّما هي غير آيات الأحكام الظاهرة في معانيها المتضمّنة لمطالب ليست أجنبية عن إدراك أحد من ذوي العقول من أهل اللسان، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؛((4)) وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيلاً﴾؛((5)) وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ﴾؛((6))
ص: 114
وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللهِ ِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله
وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾.((1))
ومثل بعض الآيات الراجعة إلى الوعد والوعيد وغيرها.
وثانياً: قياس الكتاب المبين _ الّذي أنزله الله نوراً وتبياناً وذكرى للمؤمنين الّذين إذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيماناً _ بكتب الأوائل قياس مع الفارق، فإنّ الأوائل إنّما كتبوا ما كتبوا لأجل استفادة أهل الاطّلاع وطلبة العلوم خاصّة على اصطلاحاتهم دون غيرهم، حتى أنّهم لو أرادوا أن يكتبوا ويبيّنوا مطالبهم الغامضة لاستفادة العامّة لما يمكنهم ذلك، وهذا إنّما يكون من ضعف المتکلّم وضيق دائرة علمه وقدرته على بيان مراده. ولكن أين هذا من القرآن المجيد فإنّه كتاب الله الّذي أنزله لهداية عباده عالمهم وجاهلهم أبيضهم وأسودهم، وقد بيّن الله تعالى بقدرته الكاملة المطالب العالية _ الّتي لا يمكن أداء حقّ بيانها إلّا بإلقاء الخطابات المفصّلة البليغة _ في آية مختص_رة بأحسن بيان وأجود تقرير، يستفيد منه العالم والجاهل، ويبعث کلّا منهما إلى العمل ويسوقهما إلى طريق الكمال والحركة والتفكير، ويوقظ النفوس من نوم الغفلة، وتتحرّك به العواطف، وتستعدّ به النفس الإنسانية لقبول الإفاضات الربانية.
وتأثير القرآن في ذلك إنّما هو من وجوه إعجازه، فإنّه قد بلغ في ذلك حدّاً لم يمكن أن يبلغ إليه کلام الب_شر. فالقرآن هو السبب لتحويل أخلاق عرب الجاهلية إلى الأخلاق الكاملة الإنسانية. كما يجد المتتبّع في كتب التاريخ أنّه لا يوجد سببٌ لرقيّ العرب _ في الجهات الروحانية والاجتماعية والسياسية وغيرها، ورفضها أشدّ العادات الذميمة والأخلاق الرذيلة، وتخلّقها بالأخلاق الملكوتية،وتجنّبها عمّا ينافي شعار
ص: 115
التقوى والفقه والأمانة وغيرها _ إلّا القرآن، فهو القائم بهذه الوظيفة في زمان قليل جدّاً. كما أنّ تأثيره في النفوس في زماننا هذا أيضاً أكثر من کلّ کلام وبيان، حتى أنّه لا يمكن قياس الأخبار والأحاديث في هذه الفوائد بالقرآن المجيد حتى الأخبار النبوية(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) والخطب والكلمات العلوية(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) مع كونها في غاية المتانة والبلاغة.
نعم، توجد في القرآن المجيد بعض الآيات الراجعة إلى الاُمور التكوينية الّتي ليس فهم حقيقتها قريباً من اُفق أذهان جميع الناس؛ ومصلحة النبوات لا تقتض_ي إظهار حقيقتها صراحةً، لعدم اهتداء عقول غالب الناس إلى فهمها إمّا لكونها مخالفةً لما يكون عندهم كالضروريات والاُمور المحسوسة، أو لنقصان استعداداتهم وإدراكاتهم. ومع ذلك کلّه قد اُدّي حقّ البيان في هذه الآيات أيضاً بقدر ما تقتضيه مصلحة النبوّة.
ويمكن أن يكون المراد من المتشابه هذا النوع من الآيات، وليس هذا القسم محلّا للابتلاء. هذا، مع أنّ الأخبار أيضاً متضمنةٌ لهذه المطالب العالية الغامضة.
والحاصل: أنّه لا اعتناء بهذا الكلام، أي كون احتواء القرآن على المضامين الشامخة مانعاً عن حجّية ظهوراته، لكونه مخالفاً لحكمة إنزال القرآن وكونه معجزاً، ومخالفاً للسيرة القطعية من المسلمين خلفاً عن سلف، وعمل النبيّ الأكرم(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كقراءته الآيات الكريمة على الناس.
وأمّا الجواب عن كون الأخذ بالظاهر تفسيراً بالرأي
فهو: أنّ التفسير هو كشف القناع وليس منه حمل الكلام على ظاهره.
نعم، لو كان الكلام يحتمل وجوها وحملناه على بعضها، أو كان ظاهراً في معنى وحملناه على غيره فهذا من التفسير بالرأي.
فلا يقال لمن قال بحرمة منكوحة الأب لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ
ص: 116
آبَاؤُكُمْ﴾،( ) أو حرمة نكاح الاُم لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُم اُمَّهَاتُكُمْ﴾،( ) أو محبوبية الإحسان إلى الوالدين لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً﴾،( ) أو وجوب جلد الزاني والزانية لقوله عزّ اسمه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي...﴾( ) الآية، أنّه فسّر القرآن.
وبالجملة: فالتفسير هو القول بغير العلم وليس هو الأخذ بظاهر الكلام.
وأمّا الاستدلال بالعلم الإجمالي
ففيه: أنّه ليس لنا علمٌ إجماليٌ بطروّ التخصيص والتقييد لعمومات الكتاب ومطلقاته، أو وجود قرينة التجوّز مع قطع النظر عن المراجعة إلى كتب الأخبار ممّا بأيدينا فلا مجال لدعوى هذا العلم قبل المراجعة إليها.
نعم، يمكن دعوى العلم الإجمالي بطروّ التخصيص أو التقييد لبعض عمومات الكتاب أو مطلقاته، ولكنّه بعد المراجعة إلى الأخبار والظفر بموارد التخصيص والتقييد ممّا في أيدينا ينحل إلى العلم التفصيلي والشكّ البدويّ.
ص: 117
وأمّا الاستدلال ببعض الأخبار الدالّة على أنّ علم القرآن إنّما يكون عند من خوطب به دون غيره _ الّذي هو السبب العمدة في ذهاب الأخباريين إلى عدم حجّية ظواهر الكتاب _.ففيه: أنّه ليس المراد منها عدم حجّية الظواهر وعدم جواز التمسّك بالكتاب مطلقاً، لمخالفته لسيرة كافة المسلمين والأئمّة(علیهم السلام) وأصحابهم، لأنّهم كثيراً ما يستدلّون بظواهر القرآن ويرشدون أصحابهم إلى الرجوع إليه، وعرض الأحاديث والروايات عليه، كما يظهر ذلك لمن تتبّع كتب الأحاديث.
بل المراد من هذه الأخبار مذمّة الناس من الّذين تركوا أحد أركان الحجج وعمدتها واكتفوا بالكتاب والسنّة دونه ويفتون بالقياس فيما ليس حكمه مذكوراً في الكتاب والسنّة من دون أن يرجعوا في ذلك إلى العترة مع كونهم مأمورين بذلك، ومقتضى حديث الثقلين((1)) حجّية قولهم وتوافقهما وعدم افتراقهم عن الكتاب. وهذا غير مسألة الخلافة والرئاسة، فإنّه مع قطع النظر عن ذلك _ والقول بأنّ الخلافة والرئاسة العامّة _ كما زعمه العامّة _ ليست إلّا من قبيل السلطنة والأمارة وتتحقّق بإجماع الاُمّة واتّفاقهم على تولية واحد لها، وليست من المناصب الإلهية حتى يكون طريق إثباتها منحصراً بالنصّ _ كما تقوله الفرقة المحقّة الإمامية _ يجب القول بحجّية أقوال أهل البيت(علیهم السلام) وفتاويهم وأحكامهم لحديث الثقلين.
فالأخبار المذكورة إنّما وردت لذمّ هذه الطائفة، لا مَن يتمسّك بأذيال ولاية الأئمّة(علیهم السلام) ويهتدي بهداهم ويستضيء بنورهم ويذهب إلى تخصيص عمومات الكتاب وتقييد مطلقاته بالروايات الصادرة عنهم.
وليس معنى هذه الروايات عدم حجّية الظواهر مطلقاً حتى بعد المراجعة إليهم(علیهم السلام) وإلى رواياتهم وعدم الظفر بقرينة التجوّز أو المخصّص والمقيّد.
ص: 118
والحاصل: أنّ الأخبار كما تنادي به رواية مخاطبة الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) مع أبي حنيفة((1)) وقتادة((2)) إنّما وردت في ذمّ أبي حنيفة وقتادة ومن يحذو حذوهما ممّن يجلس مجلس الفتوى ويفتي من غير أن يراجع إحدى الحجج وهو قول العترة صلوات الله عليهم، ويستغني عنهم، ويدّعي الاستقلال في فهم الكتاب والسنّة، ولا يأخذ بما صدر عن أئمّة أهل البيت(علیهم السلام) ممّا يدلّ على تخصيص عمومات الكتاب أو تقييد مطلقاته أو يكون قرينة على التجوّز.
ولا نظر لها إلى من ليس كذلك ممّن يأخذ بفتوى أئمّة أهل البيت(علیهم السلام) ويأخذ بما صدر عنهم من الفتاوى والأحكام وما هو مقيّدٌ لإطلاقات الكتاب أو مخصّص لعموماته.
ومن الواضح: أنّ مجرّد طروّ التخصيص أو التقييد لا يصير سبباً لعدم حجّية الظواهر، وإلّا فلا فرق في ذلك بين الكتاب والروايات، فكما أنّه في الروايات لا يصير ذلك سبباً لسقوطهما عن الحجّية كذلك الكتاب لا يسقط عن الحجّية بمجرّد ذلك.
إن قلت: لا مجال للتمسّك بظواهر الكتاب مع وقوع التحريف، للعلم الإجمالي
ص: 119
باحتفاف بعض الآيات الظاهرة في معنى من المعاني بما يفيد خلافه، أو وقوع بعض الزيادات المغيّرة للمعنى.
قلت: أمّا الزيادة، فالضرورة قائمة على خلافها، ولا أظنّ أحداً يلتزم بها.
وأمّا النقيصة، فربما يحتمل لما نقل عن بعض المؤرّخين من العامّة في كيفية جمع القرآن في زمان خلافة أبي بكر بتوسّط زيد بن ثابت، مع أنّ کلّ ما نقل عنهم هؤلاء ليس إلّا روايات مرسلة ضعيفة((1)).
ولما روي من أنّ أمير المؤمنين(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بعد وفاة الرسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) قال: «لا أضع ردائي حتى أجمع القرآن»، لأنّ رسول الله أمره بجمعه وأوصاه به»،((2)) وقد أتى به بعد جمعه إلى المسلمين، فلم يقبلوا منه وقالوا حسبنا ما عندنا، وقال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا يظهر ذلك إلّا بعد خروج...» الحديث.
ولبعض روايات اُخرى تقضي البديهة بتأويلها أو طرحها لما فيها ممّا يخالف القطع والضرورة، كما في بعضها من نقص ثلث القرآن، أو ربعه، أو نقص أربعين إسماً في سورة «تبّت» منها أسماء جماعة من المنافقين.
ومن الوضوح أنّ ذلك مخالف لبديهة العقل؛ لأنّه لو كان ذلك ممّا أبرزه النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) قرأه على المسلمين وكتبوه، كما قرأ عليهم الآيات المنزلة عليه، لافتضح المنافقون، مع أنّ النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لم يكن مأموراً إلّا بالستر عليهم. ولقامت الحرب على ساق، وكان في ابتداء الإسلام من الفتن ما ظهر بعد وفاة النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ). مع أنّه لو كان لتواتر نقله؛ لأنّهم
ص: 120
كانوا يضبطون جميع آياته وحروفه وكلماته تمام الضبط، فكيف يغفلون عن مثل ذلك؟! ولعرف بين الكفّار والمعاندين من أعظم معائب الإسلام والمسلمين. ولكان القرآن غير محفوظ، وقد أخبر الله بحفظه. ولعرف بين الشيعة وأعدائهم من أعظم الأدلّة على خروج الأوّلين من الدين؛ لأنّ النقص على تقدير ثبوته مستند إليهم.
ثم العجب کلّ العجب من قوم يزعمون أنّ الأخبار محفوظة في الألسن والكتب في مدّة أكثر من ألف وثلاثمائة سنة وأنّه لو حدث فيها نقص لظهر، ويحكمون بنقص القرآن وخفائه في جميع الأزمان.
أقول: احتمال النقيصة مع كونه مرجوحاً بعيد في نفسه؛ لأنّ ما روي في بعض الروايات أنّه من القرآن، يكون من حيث المضمون ومن حيث الاُسلوب والعبارة والإنشاء على نحو لا يكاد يحتمل من له أدنى معرفة بأساليب الكلام أنّه من القرآن وصدر من المصدر الّذي صدر منه الكتاب المجيد. بل لو قيس ما نقلوه مع الكلمات الفصيحة المنقولة عن الفصحاء والاُدباء لرأينا رتبته أدنى من هذه المقايسة أيضا، فكيف بالكلام المعجز الصادر عن الله تعالى النازل على رسوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بلسان عربيٍ مبينٍ؟!
وأيضاً احتماله مخالفٌ لما ثبت من أنّ أمير المؤمنين(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم كثيراً ما يستشهدون بالقرآن المجيد، ويقرّرون أصحابهم على الاستدلال به، وأنّ هذا القرآن هو القرآن الّذي اُنزل على النبيّ، كما يظهر ذلك بالمراجعة إلى الروايات ونهج البلاغة وكثيرٍ من الأدعية مثل بعض أدعية الصحيفة السجّادية، كدعائه عند ختم القرآن، وغيره.((1)) والروايات الدالّة على وجوب الأخذ بالقرآن، كقوله: «إذا التبست عليكم الفتن كقِطع الليل المظلم...» الخبر،((2)) وخبر الثقلين، وغيرهما.
ص: 121
هذا، مع أنّ هذا الاحتمال الضعيف المرجوح البعيد ليس مضرّاً بما نحن بصدده، وهو حجّية ظواهر آيات الأحكام، لأنّ العلم الإجمالي بالتحريف لو فرضنا تماميته وقبلناه مماشاةً مع الخصم ليس إلّا في غير آيات الأحكام ممّا تكون الدواعي على إسقاطه موجودة، كإسقاط کلمة «في عليّ» من قوله: ﴿بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾.((1))وأمّا ما ليس لهم داعٍ على تحريفه كآيات الأحكام فليس متعلّقاً للعلم الإجمالي أصلاً.
ولو سلّم كونه طرفاً للعلم الإجمالي، فليس هذا العلم منجّزاً مؤثّراً لكون بعض أطرافه وهو آيات غير الأحكام خارجاً عن محلّ الابتلاء فيصير بالنسبة إلى آيات الأحكام شكّاً بدويّاً، كما لا يخفى.
ثم إنّ الاختلاف في القراءات وإن كان لا يوجب الشكّ في جواز القراءة لكل واحد منها، لكون جواز القراءة بكل واحد من القراءات المعروفة السبعة بل والثلاثة الاُخرى في زمان الصادق(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) من المسلّمات عند جميع الشيعة فضلاً عن غيرهم، ولكن في مقام التمسّك لابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن ولا مجال لإعمال القواعد المقرّرة في باب الخبرين المتعارضين بالنسبة إلى اختلاف القراءات، لعدم كونه من هذا الباب.
هذا تمام الكلام في حجّية الظواهر.((2))
والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمد وآله أجمعين. اللّهمّ اغفر لنا ولوالدينا ولمعلّمينا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولمن استغفر لنا وترحّم علينا بحقّ محمد وآله.
ص: 122
إعلم: أنّ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب،((1)) أي يكون له واقع يطابقه أو لا يطابقه؛ ولا يلزم فعلية ذلك، بل يكفي كونه في حدّ ذاته كذلك.
وفي مقابله الإنشاء، لأنّه ليس له واقع يطابقه أو لا يطابقه، ولا يحتمل الصدق والكذب.
وهو (أي الخبر) على قسمين: المتواتر، و خبر الواحد.
وقد قسّم في لسان أساتيذنا وأساتيذ أساتيذنا إلى الإجماليّ والتفصيليّ.
والمراد بالإجماليّ، هو: إخبار جماعة عن القضايا المتفرّقة _ الّتي بينها جامعٌ واحدٌ أو لازمُ جميعها مطلبٌ واحدٌ _ بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويقطع بصدق واحدٍ منها.
وأمّا التفصيلي، فهو: إخبار جماعة _ يمتنع تواطؤهم على الكذب _ عن مطلبٍ واحدٍ، سواء كان المخبر عنه قول شخص، أو غيره كوجود زيد وطلوع الشمس وغيرهما.
فإن كان المخبر عنه قول أحد، وكان إخبارهم عنه نفس الكلام واللفظ بأن أخبروا کلّهم عن اللفظ الصادر من شخص يسمّى ب_ : «التواتر اللفظي» كما ربما يقال في قول: «إنّما الأعمالُ بِالنِّيات»،((1)) فإنّ نقلة هذا اللفظ عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب.
ص: 124
وإن كان إخبارهم عمّا أفاده بالكلام، وكان غرضهم من الإخبار الإخبار عن معنى اللفظ والكلام يسمّى ب_ «التواتر المعنوي».((1))
وكيف كان، فلا إشكال في حجّية الخبر المتواتر لحصول القطع بصدوره، ولا اعتناء
ص: 125
بعدم حصوله لبعض غير المستقيمين في الاستعداد والسليقة،((1)) ومن وقع في ظلمة الشكّ والوسوسة وصار من السوفسطائية.((2))
وأمّا خبر الواحد، فهو: ما ليس بمتواتر.
وقد قسّموه إلى تقسيمات عديدة:
منها: تقسيمه إلى المستفيض، وهو: الخبر الّذي كان رواته أكثر من ثلاثة أو ثلاثة وأكثر، وغير المستفيض.
ومنها: تقسيمه إلى المحفوف بالقرائن القطعية، وغيره.
ولا ريب في أنّ خبر الواحد غير المحفوف بالقرائن القطعية غير مفيد للقطع وإن كان المنقول عن بعض من العامّة كأحمد بن حنبل إفادة كلّ خبرٍ للقطع؛((3)) ونقل أيضاً
ص: 126
عن بعض الأخباريين إفادة الأخبار المنقولة في الكافي القطع، وعن بعضهم ما في الكافي والفقيه، وعن بعضهم ما فيهما وفي التهذيب والاستبصار، وعن بعضهم الآخر إفادة کلّ خبر للقطع سواء كان من الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة أو غيرها. وهذا الادّعاء أيضاً _ كادّعاء عدم إفادة المتواتر القطع _ لا يصدر إلّا عمّن ليس له سليقةٌ مستقيمةٌ، ويحصل له القطع من غير تحقّق موجبه.
وأمّا حجّية الخبر غير المحفوف بالقرائن القطعية، فلا ريب فيها في الجملة.
والمشهور بين العامّة في تمام الأعصار _ قولاً وعملاً _ حجّية خبر الواحد،((1)) كما يظهر ذلك عند المراجعة إلى كتبهم الفقهية مثل: موطّأ مالك وغيره، حتى أنّهم ربما اتّفقوا على فتوى مع كون مستندها منحصراً بخبر الواحد مثل: مسألة منجّزات المريض، فإنّهم اتّفقوا على أنّها من الثلث لا الأصل لرواية واحدة رووها عن عمران بن حصين عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)،((2)) وكثيراً ما يعتذرون عمّن أفتى في مسألة على خلاف رواية بعدم وصولها إليه، كما اعتذر محمد بن الحسن الشيباني _ أحد تلامذة أبي حنيفة _ عن كون فتوى اُستاذه في خيار المجلس على خلاف الخبر المرويّ عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وهو: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع»،((3)) بعد ما رواه الشافعي بسنده المتّصل إلى النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بأنّ أبا حنيفة لو وصل إليه هذا الخبر لعدل عن هذه الفتوى.
ص: 127
وكيف كان، فالمسألة بينهم من المسلّمات، لأنّهم لم ينقلوا الخلاف فيها بل نقلوا اتّفاق جميع الأصحاب على العمل بخبر الواحد.
نعم، نقل الشافعي: أنّ قائلاً طالبه بالدليل على حجّية الخبر، ونقلوا عن بعض متكلّميهم وعن الخوارج القول بعدم الحجّية، ونسبوه أيضاً إلى الإمامية،((1)) هذا.
والظاهر: أنّ أصحاب رسول الله التابعين كانوا متّفقين على العمل بخبر الواحد، ولم ينقل منهم خلاف إلّا في بعض الموارد عن أبي بكر وعمر.((2))
وأمّا الإمامية، فالمشهور بين متكلّميهم نفي الحجّية،((3)) ولذا كثيراً ما يجيبون عن الاستدلال بالأخبار غير المتواترة بأنّها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً. وأمّا المحدّثون والفقهاء منهم وهم معظمهم، وأصحاب الأئمّة صلوات الله عليهم فيعملون بالخبر وإن لم يكن متواتراً.((4))
ولا ريب في تحقّق الشهرة بين جميع أصحابنا في جميع الأعصار على حجّية خبر الواحد.
ص: 128
وأمّا الإجماع الّذي ادّعاه السيّد،((1)) فسيأتي ما ينبغي أن يقال فيه،((2)) فإنّه لا يخلو من الغموض. مع أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على حجّية الخبر، فإنّ الشيخرحمه الله تتلمذ عند السيدرحمه الله من سنة 413 إلى 436، ومع ذلك ادّعى الإجماع على حجّية الخبر في مقابل الإجماع الّذي ادّعاه اُستاذه السيّدرحمه الله وأنّ العمل بخبر الواحد كالعمل بالقياس في قيام الضرورة على بطلانه.
ولا يصحّ رفع التنافي بما زعمه بعض الأعلام من المعاصرين، حيث قسّم الخبر إلى الموثوق الصدور وإلى غيره، وأنّ الإجماع المدّعى على حجّية الخبر قائم على حجّية الخبر الموثوق الصدور، والإجماع المدّعى على عدم حجّيته قائم على عدم حجّية الخبر غير الموثوق بالصدور؛((3)) لعدم المجال لحمل الإجماع المدّعى على عدم الحجّية على ما حمله.
وفيه: أنّ اتّباع الخبر ليس اتّباع غير العلم، بل هو اتّباع العلم، لأنّا نتّبع الخبر بعد قيام الدليل القطعيّ على حجّيته ووجوب اتّباعه، لا بدونه. نعم، لو لم يقم دليل على حجّيته يكون اتّباعه عملاً بالظنّ وغير العلم، وأمّا معه فيكون اتّباعه اتّباع العلم، وتكون النسبة بين ما يدلّ على حجّية الخبر وهذه الآيات نسبة الورود.
والحاصل: أنّه لا فائدة للاستدلال بهذه الآيات؛ فإنّه لا يخلو إمّا أن لا تقوم حجّة على اعتبار الخبر، فلا حاجة إلى هذا الاستدلال، فإنّ الشكّ في الحجّية يغنينا عن الاستدلال على عدم جواز العمل، وإمّا أن يقوم الدليل على حجّيته كما يدّعيه القائل باعتبار خبر الواحد، فليس إذن اتّباعه اتّباع غير العلم.
فإن قلت: ما يدلّ على جواز اتّباع الخبر يكون مخصِّصاً للآيات الناهية لا وارداً عليها، فإنّ الأدلّة الدالّة على جواز العمل بالخبر إنّما تقتضي جواز اتّباع الظنّ وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف.((1))
قلت: إذا كان موضوع الدليل _ الّذي توهم كونه مخصِّصاً للعام _ خارجاً عن موضوع دليل العامّ قبل ورود هذا الدليل كما يكون بعد وروده خارجاً، كقوله: «لا تكرم زيداً» و«أكرم العلماء» إذا لم يكن زيد من العلماء تكون النسبة بين الدليلين التخصّص، ومعنى ذلك في الحقيقة عدم وجود ارتباط بينهما، بل عدم تحقّق نسبة بينهما، وأنّ کلّ واحدٍ منهما غير الآخر وغير مرتبطٍ به. وهذا، بخلاف التخصيص، كقوله: «لا تكرم زيداً العالم»، فإنّه يدلّ على عدم وجود الحكم الثابت لهذا الفرد بمقتضى «أكرم العلماء».
وأمّا في الورود فليس الفرد الخارج بسبب الدليل الوارد خارجاً عن موضوع العامّ
ص: 130
قبل وروده، بل إنّما يخرج بسبب ورود هذا الدليل عن موضوعه، لا خروجاً تعبّدياً بل خروجاً تكوينياً، كما إذا دلّ الدليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فإنّ مقتض_ى دلالة الدليل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال عن شمول قوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «مَا لَا يَعلَموُنَ» تكويناً وكون التكليف به مقطوعاً، مع أنّه لولا هذا الدليل يكون واقعاً تحت عموم قوله: «مَا لَا يَعلَموُنَ» وكان مرفوعاً.
نعم، لا مانع من القول بكون الورود أيضاً قسماً من التخصيص، فيقال: إنّه على قسمين، فتارة: يكون موضوع دليل خارجاً عن تحت الآخر قبل وروده كما يكون خارجاً بعده. وتارة: لا يكون خارجاً قبله بل يكون بحيث لو لم يرد هذا الدليل يبقى مندرجاً فيه، ولكن بعد ورود هذا الدليل خرج من موضوع الدليل الآخر تكويناً.
فعلى هذا، نقول جواباً عن الإشكال: إنّ العمل بخبر الواحد وإن كان في نفسه اتّباع غير العلم ومتابعة الظنّ الّذي لا يغني من الحقّ شيئاً، وداخلاً تحت موضوع الأدلّة الدالّة على حرمة اتّباع غير العلم، وتكون أدلّة الاعتبار الدالّة على جواز اتّباع مفاده مع كونه غير موجب للعلم بالحكم الشرعيّ الواقعي مخصِّصة للأدلّة المانعة، إلّا أنّ أصل الأدلّة الدالّة على حجّية الأمارة ووجوب اتّباعها يكون وارداً على هذه الأدلّة المانعة عن اتّباع الظنّ، لحصول القطع بالحكم الشرعي الظاهري وهو وجوب اتّباع الأمارة بعد قيام الدليل القطعي على حجّيتها، فيصير العمل بالخبر بهذا الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهريّ خارجاً عن تحت موضوع دليل عدم الجواز تكويناً لعدم كون هذا العمل عملاً بغير العلم.
وثانياً: بالأخبار، مثل: ما يدلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب، أو الخبر الّذي لم يكن موافقاً له، أو عدم صدور ما كان كذلك عنهم(علیهم السلام).((1))
ص: 131
وفيه: أنّ الظاهر من هذه الطائفة أنّها صدرت لردّ الأخبار المجعولة المناقضة للكتاب والأحاديث المكذوبة الّتي دسّوها في الروايات كثير من أرباب الآراء الفاسدة والمقاصد الباطلة وجماعة من المنتحلين إلى التشيّع، لأن يفرّقوا بين الشيعة ويميلوا الناس عن أئمّتهم لإبطال أمرهم وتحقير کلمتهم بين الناس وإطفاء نورهم ﴿ وَ يَأْبَى اللهُ إلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.((1)) فهذه الأخبار إنّما صدرت في مقابل هؤلاء، وما يكذبون عليهم(علیهم السلام).
كما أنّ الظاهر أنّ جلّ هذه الروايات المجعولة راجعة إلى اُصول الدين وما ينافي التوحيد الإسلامي وسائر مبانيه المحكمة المسلّمة عند الكل. وأنّ مثل قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا یصدق علينا إلّا ما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)»((2)) راجع إلى الردع عن الأخذ بهذه الروايات.
ومثل: ما ورد عنهم من الأخبار في علاج الخبرين المتعارضين ووجوب الأخذ بما كان موافقاً للكتاب وطرح المخالف.((3))
وأنت خبير بأنّه لا ربط لهذه الأخبار بمحلّ الكلام، بل تدلّ على حجّية الخبر في الجملة.
ومثل ما يدلّ على طرح الخبر الّذي لم يوجد له شاهد أو شاهدان من الكتاب.((4))
وفيه: أنّ فساد الاستدلال بهذه الأخبار _ مع كونها أخبار آحاد بل ربما لا تتجاوز عن اثنين _ لإثبات عدم حجّية الخبر أوضح من أن يخفى.
اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّا إمّا أن نقول بحجية الخبر أم لا، فعلى الثاني لا كلام بيننا؛ وأمّا
ص: 132
على الأوّل فتكون هذه الأخبار نافية لحجّية الخبر فتقع المعارضة بينهما، فلا يبقى ما يدلّ على الحجّية.
وفيه: أنّ بعد قيام الدليل القطعي على حجّية الخبر _ كما سيأتي إن شاء الله تعالى((1)) _ لا مجال لمعارضة هذه الأخبار معه.
وثالثاً: بالإجماع، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.((2))
وحاصل الكلام: أنّ إثبات عدم حجّية الخبر مع عدم قيام دليل قطعي عليها غير محتاج إلى إقامة البرهان، لكونه موافقاً للأصل؛ ومع قيام الدليل القطعي فلا مجال إلّا للأخذ به.
فعلى هذا، ينبغي لنا طيّ المقال وصرف عنان الكلام إلى بيان ما أفادوا لإثبات حجّية الخبر.
استدلّوا لإثبات حجّية الخبر بالأدلّة الأربعة، فنبدأ في بيانها، وعلى الله التوكّل وبه الاعتصام:
إعلم: أنّه استدلّ لحجّية خبر الواحد بآيات من الكتاب الكريم، منها قوله
ص: 133
تعالى في سورة الحجرات: ﴿يَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنبأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيِبُوا قَوْماً بِجَهالةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.((1))
وقد اُفيد في مقام الاستدلال بهذه الآية بأنّه قد علّق وجوب التبيّن على مجيء الفاسق بالخبر، فينتفي عند انتفائه. فإذا انتفى وجوب التبيّن والاستيضاح عند مجيء غير الفاسق به فإمّا أن يجب القبول وهو المطلوب، وإمّا أن يجب الردّ وهو فاسد للزوم كون العادل أسوأ حالاً من الفاسق.((2))
ولكن لا يخفى عليك: أنّه ليس التبيّن وطلب الوضوح والتثبّت في خبر الفاسق واجباً نفسّياً بالأصالة، ولا يفهم من الآية كونه واجباً نفسّياً رأساً، لعدم كون الآية في مقام بيان وجوب هذا التثبّت وكونه كسائر الواجبات الشرعية، بل الظاهر أنّ الآية مسوقة لبيان حرمة العمل بالخبر الّذي جاء به الفاسق قبل التثبّت وهذا لا إشكال فيه.
وإنّما الإشكال في أنّ الاستدلال بهذه الآية هل يكون مبنيّاً على مفهوم الش_رط أو الوصف؟ ويظهر من الكفاية أنّ الاستدلال بها من جهة مفهوم الش_رط، فيكون الموضوع لحرمة العمل هو النبأ الّذي جيء به إذا كان الجائي به فاسقاً، فبانتفاء هذا القيد ينتفي الحكم.((3))
وفيه: أنّ الظاهر أنّ القضية المستفادة من الآية مسوقة لبيان تحقّق الموضوع مثل: «إن رزقت ولداً فاختنه»، ولا يؤخذ الموضوع فيه _ خارجاً _ مفروض الوجود حتى يكون انتفاء الشرط مستلزماً لانتفاء الجزاء، فليست الآية من قبيل قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «الماء إذَا
ص: 134
َکانَ قدر كرّ لم ينجّسه شيء»، فإنّ موضوعه وهو «الماء» محقّق الوجود في الخارج، فبانتفاء الش_رط ينتفي حكمه. أمّا شرط وجوب الختان _ أعني رزق الولد _ لو انتفى فلا ينبغي أن يقال بانتفاء حكمه، لعدم وجود أصل موضوعه في البين.
والآية أيضاً تكون في مقام إفادة أنّ مجيء الفاسق بالنبأ لو تحقّق يحرم العمل به قبل التثبّت، لا أنّ النبأ إذا كان الجائي به فاسقاً يحرم العمل به، فلا ينبغي الالتفات إلى الاستدلال بالآية من جهة مفهوم الشرط ولو فرضنا لها مفهوماً، ولا يكون إلّا من السالبة بانتفاء الموضوع.
وإن شئت مزيد توضيح لذلك نقول: إنّ القضيّة الشرطية مسوقة لبيان تحقّق الموضوع إذا كان وجود الجزاء _ المذكور فيها _ متوقّفاً على وجود الشرط مثل: «إن ركب الأمير فخذ ركابه»، فإنّ وجوب أخذ الركاب لا يتحقّق إلّا إذا ركب الأمير، ومع عدم الركوب لا يمكن تحقّق الجزاء؛ وهذا بخلاف «إن جاءك زيد فأكرمه»، فإنّ وجوب إكرام زيد لا يتوقّف على المجيء بل هو ممكن مع عدم مجيئه، فالقضيّة الاُولى لا تكون مسوقة لإفادة المفهوم بل لبيان تحقّق الموضوع، بخلاف القضيّة الثانية.
وما يستفاد من الآية هو كونها مسوقة لبيان تحقّق الموضوع، فإنّ الجزاء معلّق فيها على مجيء الفاسق بالخبر، فيكون وجوب التبيّن متوقّفاً على مجيء الفاسق بالخبر، أمّا مع عدم مجيئه بالخبر فلا يمكن تحقّق التبيّن. ومجرّد ذكر الش_رط في حيّز الش_رط لا يوجب كون القضيّة ذات مفهوم.
فعلى هذا، لا يتمّ الاستدلال بمفهوم الشرط، لعدم كون القضيّة مسوقة لإفادة المفهوم.
نعم، لو كان الموضوع في القضيّة الشرطية المستفادة من الآية نفس النبأ، وعلّق الجزاء على الشرط، كما لو قيل في جواب من سأل عن حكم النبأ: «إذا جاء به الفاسق فتبيّن» يتمّ الاستدلال بالمفهوم. وأمّا في مثل الآية الّتي ظاهرها أنّها مسوقة لبيان تحقّق الموضوع فليس أخذ المفهوم في محلّه.
ص: 135
والحاصل: أنّ القول بالمفهوم من جهة الجملة الش_رطية هنا لا يتمّ إلّا بالتمحّل والتكلّف.
وهكذا من جهة الوصف: فإنّ القضيّة الوصفيّة ليست ذات مفهوم عند المتأخّرين، خصوصاً إذا كان الوصف المذكور فيها غير معتمد على الموصوف. هذا کلّه بناءً على مسلك المتأخّرين، وكون المفهوم قسماً من المدلول بالدلالة الالتزامية، كما أفادوا وقالوا بأنّ حجّيته _ لو ثبت أصله _ غنيّة عن البيان، وصاروا في مقام إثبات أصل المفهوم من طريق ظهور ذكر العلّة في انحصارها، وجعلوا النزاع في باب المفاهيم صغروياً.
وأمّا بناءً على ما حقّقناه في مبحث المفاهيم _ تبعاً لقدماء الاُصوليين _ من عدم كون المفهوم من سنخ المنطوق أصلاً، بل هو مستفاد من إتيان المتکلّم بقيد زائد في کلامه لكونه فعلاً اختيارياً يفعله الحكيم لغاية وفائدة، وغايته الظاهرة في الكلام إفادة معنى القيد الزائد الّذي أتى به في کلامه، فيستفاد من هذا القيد دخالته في الحكم صوناً لفعل الحكيم عن اللغوية، ولا يفيد ذلك أكثر من دخالة القيد وأنّ المقيّد بما هو هو لا يكون موضوعاً للحكم، فلا مانع من ضمّ قيد آخر إليه وقيامه مقامه، كما أفاده السيّد(قدس سره). ولا فرق في ذلك بين ما كان القيد الزائد المأتيّ به في الكلام من أدوات الش_رط أو الوصف أو الغاية؛ لأنّ كلّها في ما ذكر على وزان واحد، ولذا ترى القدماء في مقام الاستدلال بالآية المذكورة لم يفرّقوا بين مفهوم الوصف والشرط، وإنّما أفادوا بأنّ اشتمال الكلام على القيد الزائد مفيد لدخله في الحكم.
فعلى هذا، لا مانع من القول بالمفهوم من جهة اشتمال الآية على قيدٍ زائد وهو الوصف المذكور فيه؛ فإنّ ذكره يدلّ على دخالته في الحكم، فإنّ النبأ لو كان تامّاً في الموضوعية لكان الإتيان بقيد «كون الجائي به فاسقاً» لغواً، فيستفاد من الإتيان بهذا القيد دخل صفة فسق الجائي بالنبأ في موضوع وجوب التبيّن، وأنّه ليس بنفسه _ ومجرّداً _ مَركباً لحكم الشارع بوجوب التبيّن.
ص: 136
ولا يأتي هذا التقريب في الشرط، لما قد ذكرنا من أنّه إذا كان الجزاء متوقّفاً على وجود الشرط لا يمكن أخذ المفهوم ولا تكون القضيّة مسوقة لإفادة المفهوم، بل القضيّة إذا كان كذلك تكون مسوقة لبيان تحقّق الموضوع.
والحاصل: أنّ الوصف المأتيّ به في الآية يدلّ على دخله في الحكم، وعليه يتّجه القول باستفادة المفهوم من الآية. هذا تمام الكلام في بيان ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال بمفهوم آية النبأ، والله تعالى أعلم.
وقد أوردوا على استفادة المفهوم والاستدلال به بوجوه نذكر بعضاً منها.
أحدها: ما عن بعض المتقدّمين كالشيخ(قدس سره) في العدّة((1)) وغيره،((2)) وهو: أنّ الإتيان بالوصف وكلّ قيدٍ زائدٍ إنّما يدلّ على المفهوم ودخل القيد في الحكم إذا لم تكن في البين قرينة على خلاف ذلك، كأن تكون للقيد المأتيّ به فائدة ظاهرة عرفاً غير دخله في الحكم، مع أنّها موجودة في ما نحن فيه وهي عبارة عن: التعليل المذكور في ذيل الآية، فإنّه يدلّ على أنّ ما هو العلّة لوجوب التبيّن ليس إلّا عدم إصابة القوم في الجهالة والوقوع في الندامة، وهو مشترك بين خبر العادل والفاسق.
هذا مضافاً إلى إمكان أن يكون ذكر ذلك القيد لإظهار فسق الوليد؛((3)) فإنّ مورد
ص: 137
نزول الآية كان إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، وذكر الوصف إنّما يكون لأجل التنبيه على فسق هذا الفاسق.((1))
ثانيها: أنّ من المعلوم كون المعلول تابعاً لعلّته في العموم والخصوص، فالعلّة كما تخصّص مورد المعلول تكون معمّمة له أيضاً، فإنّ التعليل المذكور في قولنا مثلاً: «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض» كما يخصّص الحكم بالأفراد الحامضة من الرمّان، يكون معمّماً له بالنسبة إلى غير الرّمان ممّا يكون متّصفاً بالحموضة.
فعلى هذا، لا يصحّ التمسّك بالمفهوم مع وجود التعليل المذكور في ذيل الآية، فإنّ حرمة العمل بقول الفاسق بدون التبيّن قد علّلت بمقتضى هذا التعليل بكونه معرضاً لإصابة القوم بالجهالة الموجبة لحصول الندامة، وهو مشترك بين خبر العادل والفاسق وإن كانت معرضية خبر الفاسق لذلك آكد من جهة أنّ احتمال الخلاف في نبأ الفاسق يكون لأجل احتمال تعمّده الكذب ولأجل خطأه واشتباهه، وفي نبأ العادل لأجل احتمال اشتباهه دون تعمّده، ولو سلّم ذلك فلا مجال لإنكار ضعف احتماله.
واُجيب عن هذا الإشكال بكون النسبة بين المفهوم والتعليل العموم والخصوص المطلق فيجب أن يحمل العامّ على الخاصّ.
وفيه: أنّ حمل العامّ على الخاصّ إنّما يكون لأجل نصوصية الخاصّ وظهور العامّ في مورد الخاصّ فيحمل العامّ على الخاصّ حملاً للظاهر على النص، وليس ظهور الجملة في المفهوم أقوى من ظهور العامّ حتى يحمل العامّ عليه. هذا مضافاً إلى أنّ التعليل المذكور مانع عن انعقاد ظهور الجملة في المفهوم حتى يقال بتعارضهما وحمل إحداهما على الآخر.
ص: 138
وقد يجاب عنه: بأنّ الجهالة المذكورة ليس معناها عدم العلم حتى يكون مشتركاً بين العمل بخبر العادل والفاسق، بل المراد منها هو السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره عن العقلاء، وهذا غير موجود في العمل بخبر العادل.((1))
وفيه أوّلاً: أنّ هذا خلاف الظاهر من لفظ الجهالة.
وثانياً: لو سلّمنا احتمال هذا اللفظ لهذا المعنى يصير التعليل مجملاً، ومعه لا يمكن التمسّك بالمفهوم لوجود ما يصلح للقرينية على إرادة الخلاف. ولا يرفع هذا الإشكال وجود القدر المتيقّن؛ لأنّ إجمال التعليل مانعٌ عن انعقاد ظهورٍ للمعلّل.
وربما يجاب عن هذا الإشكال بأنّ وزان ذيل الآية ووزان سائر الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واتّباع الظنّ واحدٌ، ولكن يخصّص هذا العموم بظهور الجملة في المفهوم.((2))
وقد اُجيب أيضاً عن الإشكال المذكور بأنّ العلّة الموجبة لوجوب التبين وإن كانت إصابة القوم بجهالة ومعرضية خبر الفاسق لإصابة القوم بها، ولكن ليست هذه بنفسها علة لوجوب التبين بل بملاك حصول الندامة على الأخذ بقول الفاسق والعمل على طبقه، والظاهر أنّ الندامة المذكورة هي الندامة الاُخروية الحاصلة من رؤية العذاب وحين المحاسبة، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَ_مَّا رَأَوُا العَذَابَ﴾((3)) لا الندامة الدنيوية، وحيث إنّ ملاك الندامة الاُخروية غير معلوم لنا ولا يعلم إلّا من قبل الشارع يصير التعليل مجملاً ولا يمكن استفادة عمومه لخبر غير الفاسق، فلا مانع من استفادة
ص: 139
المفهوم لانعقاد ظهوره، فالتعليل يكون شبيهاً بالإيعادات المذكورة في بعض الآيات بعد بيان الأحكام ليكون مؤكّداً في البعث والزجر.
وفيه أوّلاً: أنّا لا نسلّم أن يكون المراد بالندامة الندامة الاُخروية، بل المراد بها الندامة الدنيوية.
وثانياً: أنّه وإن كانت سببية الأفعال للعذاب والعقاب وحصول الندامة في الآخرة على الأعمال لا تعلم إلّا من قبل الشارع وبيانه، إلّا أنّه قد بيّن في الآية الش_ريفة كون إصابة القوم بجهالة علّة لحصول الندامة وهي مشتركة بين خبر العادل والفاسق، كما لا يخفى.
وقد أجاب بعضٌ من أعاظم المعاصرين عن التعارض المذكور بين التعليل وظهور الجملة في المفهوم بحكومة المفهوم على التعليل؛ لأنّ المفهوم يدلّ على إلغاء احتمال مخالفة خبر العادل للواقع وكون الأخذ به أخذاً بالعلم تش_ريعاً وجعله محرزاً للواقع وكاشفاً عنه، فلا يشمله عموم التعليل، لا لأجل تخصيصه بالمفهوم بل لحكومة المفهوم عليه وكونه كالمفسّر له. فأقصى ما يقتضيه العموم هو عدم جواز العمل بما وراء العلم، والمفهوم يقتضي أن يكون خبر العدل علماً في عالم التشريع وموجباً لتضييق موضوع عموم التعليل وإخراج خبر العادل عنه موضوعاً بجعله محرزاً للواقع وحجةً، فلا تعارض بينهما، لأنّ المحكوم لا يعارض الحاكم ولو كان ظهور المحكوم أقوى منه.((1))
وفيه أوّلاً: أنّ اتّصال التعليل بصدر الآية مانعٌ عن ظهوره في المفهوم، ودليل على أنّ الإتيان بالقيد الزائد إنّما يكون لأجل إفادة نكتةٍ اُخرى.
وثانياً: سلّمنا أنّه مقيّدٌ للمفهوم وأنّ خبر العادل لا يجب فيه التبيّن، ولكن ليس للمفهوم لسانٌ حتى يقال بكونه كالمفسّر لدليلٍ آخر وناظراً إليه وحاكماً عليه، هذا.
ص: 140
ويمكن أن يقال: إنّ الإتيان في الكلام بقيدٍ زائدٍ يدلّ على دخله في الحكم مع ذكر التعليل الشامل لهذا القيد وغيره لا يكون عند العرف خالياً عن التهافت والمناقضة، فلو كان الكلام صادراً من المتکلّم الحكيم يوجّهونه على نحو يصير خارجاً عن التهافت واللغوية. وفي المقام يمكن أن يقال بأنّ العرف حيث يرى أنّ احتمال كون خبر الفاسق على خلاف الواقع ينشأ من تعمّده الكذب وإلقاء الغير في خلاف الواقع ومن احتمال النسيان والخطأ، وأمّا في خبر العادل فلا ينشأ إلّا من احتمال نسيانه وخطأه، وأمّا احتمال تعمّد الكذب فهو بالنسبة إليه بعيدٌ للغاية ولا يعتنى به، يحكم بأنّ مناسبة التعليل لوجوب التبيّن في خبر الفاسق دون العادل هي وجود احتمال تعمّد الكذب في خبر الفاسق دون العادل وعدم الاعتناء باحتمال الخطأ والنسيان فكأنّهم يفرضون الخبر _ الّذي لا يتطرّق إليه احتمال كونه على خلاف الواقع وإصابة القوم بجهالة إلّا من جهة احتمال النسيان والخطأ _ كالعلم في عدم تطرّق احتمال الخلاف إليه، وعدم كون العمل به إصابة القوم بجهالة، ولا يعتنون بالاحتمال المذكور في مقام العمل، ولهذا اُتي بالقيد في الآية تنبيهاً على الفرق الموجود بين الفاسق والعادل الّذي هو الموجب لحرمة العمل بخبر الفاسق قبل التبيّن وجوازه في خبر العادل.
ثالثها: ما لا يختصّ بمفهوم آية النبأ بل اُورد على مطلق ما استدلّ به على حجّية الخبر وهو: أنّ الآية وغيرها إنّما تقتضي حجّية الخبر إذا كان بلا واسطة، وأمّا الأخبار مع الواسطة فليست مشمولةً لها لانص_راف النبأ عن الخبر مع الواسطة، وليست الروايات والأخبار المرويّة عن الأئمّة(علیهم السلام) إلّا كذلك، فلا تشملها أدلّة حجّية الخبر.((1))
وفيه: أنّ إخبار الشيخرحمه الله عن خبر المفيد وإخبار
ص: 141
الصدوق عن خبر الكليني وكذا الكليني إلى أن ينتهي إلى الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، کلّها أخبار بلا واسطةٍ، فإنّ الشيخ أخبر عن المفيد بلا واسطةٍ وهو أخبر عن خبر الصدوق بلا واسطةٍ والصدوق أخبر عن الكليني بلا واسطةٍ وكذا الكليني إلى أن ينتهي إلى الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، فليس في البين خبرٌ مع الواسطة حتى يقال بانص_راف النبأ عنه، بل کلّ واحدٍ خبرٌ بلا واسطةٍ. وكأنّه توهّم هذا المستشكل أنّ أدلّة حجّية الخبر إنّما تشمل نفس الخبر المرويّ عن الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) فتنصرف إلى الخبر بلا واسطةٍ فلا تشمل الروايات المأثورة عنهم بوسائط أو واسطتين.
إن قلت: نعم، ولكن شمول دليل الحجّية لخبر الصدوق الّذي أخبر به الشيخ متوقّف على كونه محرزاً بالوجدان مع أنّه ليس محرزاً بالوجدان. نعم، إخبار الشيخ(قدس سره) عن الصدوق محرز بالوجدان وأمّا خبر الصدوق وسائر الوسائط فليست محرزةً كذلك بل إنّما يراد إحرازها بالتعبّد وبسبب دليل الحجّية. ولو قلنا بكفاية إحرازها بالتعبّد وبسبب دليل الحجّية في ترتّب الحكم عليه يلزم أن يكون الحكم مثبتاً لموضوعه، وهو محال.
وبالجملة: لا يكاد أن يشمل الحكم فرداً تتوقّف فرديّته على نفس الحكم ويكون ثبوته في مورد فردٍ آخر.
فلو قلنا بأنّ الحكم بتصديق العادل يجعل خبر الصدوق الّذي أخبر به الشيخ محرزاً تعبّداً، وقلنا بشمول هذا الحكم، أي الحكم بتصديق خبر العادل، لذلك أي خبر الصدوق _ الّذي اُحرز بنفس الحكم بتصديق خبر العادل _ يلزم أن يكون الحكم مثبتاً لموضوعه، لتوقّف فردية خبر الصدوق على فرديّة خبر الشيخ.
قلت: نعم، وإن كان لا يجوز أن يكون الحكم مثبتاً لموضوعه، إلّا أنّ لنا أن نقول بأنّ الحكم بوجوب تصديق خبر الشيخ _ الّذي يكون محرزاً لخبر الصدوق تعبّداً _ ليس نفس الحكم بوجوب تصديق خبر الصدوق بل هو غيره، والحكم الّذي يمتنع أن
ص: 142
يكون مثبتاً لموضوعه هو نفس حكم ذلك الموضوع، ولكن لا مانع من إثبات موضوع بسبب حكم موضوع آخر، وبعد ثبوته يترتّب عليه حكمه كما فيما نحن فيه؛ فإنّ بسبب الحكم بوجوب تصديق خبر الشيخ اُحرز خبر الصدوق، وهو موضوعٌ لوجوب تصديقه الّذي يكون وجوبه غير وجوب تصديق خبر الشيخ.
هذا مضافاً إلى أنّ خبرية خبر الصدوق بوجوده الخارجي وفرديّته للحكم بوجوب التصديق كذلك لا تكون متوقّفةً على الحكم وثبوته في مورد فرد آخر، بل إنّما تكون خبريّته بوجوده العلمي متوقّفةً على ثبوت الحكم لبعض الأفراد، وهذا لا مانع منه.((1))
إن قلت: نعم، ولكن التعبّد بالخبر وبكلّ أمارة إنّما يصحّ إذا كان للموضوع _ الّذي قامت عليه الأمارة _ بنفسه أثرٌ حتى يترتّب عليه ذلك الأثر بسبب التعبّد، وإلّا فلو لم يكن له أثرٌ لما صح جعله طريقا والتعبّد به، فالتعبّد بخبر العدل القائم على عدالة أحدٍ ووجوب تصديقه يجوز لأجل ما يترتّب على عدالته من الآثار من جواز الصلاة خلفه والطلاق عنده ووجوب قبول شهادته ونحو ذلك.
فعلى هذا، لابدّ من أن يكون ترتّب الأثر على الموضوع مفروغاً منه حتى يصحّ التعبّد بالأمارة القائمة على ذلك الموضوع، فبناءً على ذلك لا مانع من التعبّد بخبر زرارة عن الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بوجوب شيءٍ أو حرمته لما يترتّب عليه من وجوب هذا الش_يء أو حرمته. وأمّا إذا كان الخبر خبراً مع الواسطة كخبر المفيد عن الصدوق الّذي أخبر به الشيخ فلا يترتّب عليه أثرٌ شرعيٌ حتى يجوز التعبّد بخبر الشيخ الّذي أخبر عنه، ولا يجوز الحكم بوجوب تصديقه.
ولا يكفي في ترتّب الأثر الشرعي على خبر الصدوق نفس هذا الحكم بوجوب
ص: 143
التصديق، لأنّ هذا الأثر لم يكن ثابتاً له قبل دليل الحجّية، بل لم يجئ إلّا من قبل دليل الحجّية، فيتوقّف الحكم بوجوب تصديق خبر الشيخ على كون خبر الصدوق _ الّذي أخبر به الشيخ _ محكوماً بوجوب التصديق، وكونه محكوماً بوجوب التصديق متوقّف على هذا الحكم.
قلت: نعم، هذا إنّما يتمّ إذا كان الحكم بوجوب التصديق بلحاظ الأفراد وأشخاص الآثار، ولكن لنا أن نقول: إنّ الحكم إنّما يكون بلحاظ طبيعة الأثر وكون القضية طبيعية، دون لحاظ خصوصيات الآثار، فيسري الحكم على هذا إلى نفس هذا الحكم ضرورة سراية الطبيعة إلى جميع أفرادها.((1))
إن قلت: سلّمنا ذلك، ولكن الحكم بوجوب تصديق خبر الشيخ متوقّفٌ على الحكم بوجوب تصديق خبر الصدوق مثلاً، وهو متوقّفٌ على كونه محرزاً بالتعبّد، وكونه كذلك متوقّفٌ على الحكم بوجوب تصديق خبر الشيخ، وهذا دور.
قلت: كما أنّ في قيام الطريق على الحكم الواقعي أو موضوعه تكون مرتبة الحكم الواقعي متقدّمة على الأمارة، والحكم الظاهري واقعاً في طول الحكم الواقعي ولا يتوقّف وجود الحكم الواقعي على الحكم الظاهري، لأنّه موجود إمّا على نحو الشأنية أو الفعلية؛ كذلك إذا قام الطريق على الطريق والحكم الظاهري على الحكم الظاهري يكون الحكم الظاهري الّذي قام عليه الطريق بحسب الرتبة متقدّماً على طريقه، مثلاً: إذا أخبر زرارة عن الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بشيءٍ يكون ما أخبر به من الحكم الواقعي كوجوب هذا الشيء أو حرمته متقدّماً على إخبار زرارة ويكون إخبار زرارة الّذي هو الطريق للحكم الواقعي متقدّماً على الطريق القائم عليه وهو إخبار حريزٍ عن زرارة، وإخباره
ص: 144
عن زرارة أيضا متقدّماً على الطريق القائم عليه وهو إخبار حمّاد، وهو أيضاً يكون متقدّماً على إخبار أحمد بن محمد عنه، وهو أيضاً متقدّم على خبر محمد بن يحيى عنه، وهو متقدّم على خبر الكليني عنه. فعلى هذا، وإن كان الحكم بوجوب تصديق الكليني مثلاً وشمول «صدّق العادل» له متوقّفاً على الحكم بوجوب تصديق خبر محمد بن يحيى لكنّه ليس متوقّفاً على وجوب تصديق خبر الكليني، لكونه موجوداً بنحو الشأنية أو الفعلية مع قطع النظر عن قيام خبر الكليني عليه.
فإن قلت: إنّ هذا يتمّ لو لم يكن شمول الحكم لخبر الكليني ومحمد بن يحيى وأحمد بن محمد وجميع الوسائط في عرضٍ واحدٍ، أمّا مع كون شموله لجميع أخبار الوسائط على حدٍّ سواءٍ وعدم وجود ترتّبٍ وطوليةٍ بينها فلا يكفي ما قلت في الجواب. وبعبارة اُخرى: لا يمكن إنشاء الحكم بلحاظ الأفراد الطولية؛ لأنّ هذه الأفراد إنّما تتولّد بعد شمول الحكم لها، دون الأفراد العرضية لإمكان لحاظها في مقام جعل الحكم.
قلت: هذا إذا لم تكن القضيّة المنشأة للحكم من القضايا المحصورة الحقيقية، فإنّها لو كانت كذلك فلا مانع من شمول الحكم لجميع الأفراد العرضية والطولية.((1))
ولا يخفى عليك: أنّه لا يلزم في جعل وجوب التصديق وترتيب الأثر على خبر العادل كونه ذا أثرٍ شرعيٍّ عملي، بل يكفي في ذلك انتهاؤه إلى الأثر الش_رعي العملي فهذا يكفي مصحّحاً لجعل الحكم. هذا تمام الجواب عن هذا الإشكال.
وأمّا ما جاء في بعض کلمات الأكابر في مقام الجواب عن هذا الإيراد بأنّه يكفي في دفع الإشكال كون کلّ واحد من الوسائط جزء الموضوع لدخله في ثبوت قول الإمام، فيشمله الحكم بوجوب التصديق لأجل هذا الأثر.((2))
ص: 145
ففيه: أنّ هذا إنّما يتمّ إذا قامت الأمارات المتعدّدة على أجزاء موضوع حكمٍ واحدٍ، مثل: قيام خبرٍ على إخبار زيد بكذا، وقيام خبرٍ آخر على عدالته، فيشمل کلّاً منهما دليلُ التعبّد بالخبر لإثبات ما هو الموضوع للحكم الشرعي بسببهما، وهو خبر العادل. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ لأنّ خبر کلّ واحدٍ من الكليني ومحمد بن يحيى وأحمد بن محمد وحماد وزرارة يكون خبراً مستقلًّا وموضوعاً خاصّاً لوجوب تصديق خبر العادل.
رابعها: وهو ممّا اُورد على الاستدلال بخصوص آية النبأ: أنّ الالتزام بصحّة هذا الاستدلال يستلزم خروج المورد عن عموم المفهوم مع أنّ العامّ نصٌ في مورده، وإخراج مورده وتخصيصه به مستهجنٌ قبيحٌ؛ وذلك لأنّ مورد نزول الآية الش_ريفة هو الإخبار بالارتداد وهو كغيره من الموضوعات الخارجية لا يثبت إلّا بالبينة وخبر العدلين لا عدلٌ واحدٌ، سيّما في مثل المورد الّذي يكون من الاُمور المهمّة في نظر الشرع، فلابدّ من تخصيص عموم المفهوم على نحو ينطبق مع المورد، ومع تخصيصه يسقط الاستدلال به لحجّية خبر الواحد.
وقد أجاب الشيخ(قدس سره) عن هذا الإشكال كما يستفاد من رسائله أوّلاً: بعدم كون المورد داخلاً في المفهوم بل هو داخلٌ في المنطوق، فإنّ المورد هو إخبار الوليد الفاسق بارتداد بني المصطلق، والآية تدلّ بمنطوقها على وجوب الفحص والتبيّن في خبر الفاسق سواءٌ كان في الموضوعات الخارجية أو الأحكام، ولا ربط لذلك بمسألة عدم إثبات الموضوعات الخارجية إلّا بالبينة، ولا يكون هذا إخراجاً لمورد الآية عن عموم المنطوق.
وثانياً: لو أغمضنا عن هذا، وقلنا بأنّ أصل الإخبار عن الارتداد يكون مورداً للحكم بوجوب التبيّن إذا كان الجائي به فاسقاً وعدم وجوب التبيّن إذا كان عادلاً، نمنع كون ذلك تخصيصاً ومن إخراج المورد المستهجن، بل غاية الأمر كونه تقييداً
ص: 146
للحكم في طرف المفهوم، وكون حجّية خبر العدل الواحد مقيّداً بقيام خبر عدل آخر على طبقه أيضاً.((1))
ولا يخفى عليك: ما في جوابه الأوّل؛ فإنّ المفهوم ليس حاله حال غيره من الأدلّة الابتدائية مثل عموم المنطوق في الآية الش_ريفة، بل هو ما يستفاد من الخصوصية الموجودة في المنطوق وهي إتيان المتکلّم بقيد زائدٍ في المنطوق، وليس له استقلاليةٌ ونفسيةٌ كالمنطوق، بل هو تابعٌ للمنطوق ومن لوازمه وخواصه، فيكون تابعاً للمنطوق في الإطلاق والاشتراط والتعميم والتخصيص والسعة والضيق.
وأمّا جوابه الثاني ففيه: أنّ البيّنة القائمة على الموضوعات حجّة واحدةٌ وليس کلّ واحدٍ من الخبرين حجّة بشرط ضمّ الآخر به، كما لا يخفى.
ومن جملة الآيات الّتي استدلّ بها على حجّية خبر الواحد آية النفر.
قال الله تبارك وتعالى في سورة البراءة: ﴿وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.((2))
إعلم: أنّه يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من ظاهر الآية أنّها في مقام بيان كمال التأكيد والترغيب إلى تحصيل العلم والتفقّه في الدين، وأنّه من الحوائج المهمّة لنوع الإنسان،
ص: 147
ويقتضي لشدّة أهمّيته والاحتياج إليه أن ينفر جميع الناس للتفقّه في الدين وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم إلّا أنّ مزاحمته مع القيام بسائر الاُمور الحياتية والمدنية منعت عن تأثيره في وجوب النفر على الجميع للتفقّه في الدين، فحينئذٍ يجب أن يعامل معه معاملة سائر الاُمور الحياتية المهمّة، وأن ينفر من کلّ فرقةٍ وجمعيةٍ وأهل کلّ صقعٍ وبلدٍ بعضهم لتحصيل العلم وتعلّم الأحكام، كما يتعهّد کلّ واحد منهم شأناً من شؤونهم وحاجةً من حوائجهم، وعليه بنوا نظام معاشهم وتمدّنهم، وإذا كان هذا حالهم في أمر الدنيا فكيف بما كان مؤثّراً في مصلحة دنياهم وآخرتهم ونظم جميع جهاتهم الروحانية والجسمانية وكمال القوّة العلمية والعملية وهو: التفقّه في الدين، فيجب بحكم الآية أن ينفر من کلّ فرقةٍ طائفةٌ.
ولا يصغى إلى ما قيل بأنّ مقتضى سياق آيات سورة البراءة كون هذه الآية أيضاً في مقام بيان وجوب النفر إلى الجهاد والمقاتلة مع الأعداء وما يحصل منه من الفوائد للنافرين والمتخلّفين.
فإنّه مضافاً إلى أنّ ملاحظة وحدة السياق بهذا النحو في القرآن الّذي أنزله الله تعالى منجّماً مرجوحة في نفسها، وممّا يقطع بخلافه، فيه: أنّ سورة البراءة وإن كانت نزلت لذلك وكانت فيها آياتٌ كثيرةٌ راجعةً إلى الجهاد والمقاتلة مع المشركين إلّا أنّها متضمّنةٌ لآياتٍ كثيرةٍ اُخرى متضمّنةٍ بيان الأحكام وغيرها من المطالب، كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُ_شْرِكينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ...﴾((1)) الآية.
وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله... ﴾.((2)) الآیة.
ص: 148
وآية: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْ_حَاجِّ... الآية﴾((1))، وغيرها من الآيات في هذه السورة المباركة.
فوحدة السياق ولو كانت ممّا يعتنى به في موارد من الكتاب الكريم إلّا أنّها ليست قاعدةً عامَّةً شاملةً لجميع آيات الكتاب حتى تفسّر لأجلها الآية بالآيات السابقة عليها ويترك ما هو الظاهر منها، وقد ورد أنّ الآية يمكن أن يكون صدرها في أمرٍ وذيلها في أمرٍ آخر. نعم، وحدة السياق أيضاً كسائر القرائن وما يحفّ به الكلام لها دخلٌ _ حسب الموارد _ في استظهار المراد، ولكنّها ليست في جميع الكتاب قرينة على حمل ما تكون الآية ظاهرةً فيه بنفسها على غيره.
ولا يخفى عليك: أنّ المراد بالإنذار المذكور في الآية الشريفة _ الّذي جعل كالتفقّه في الدين وفي عرضه فائدة للنفر وغاية له _ ليس مجرّد الإنذار والتخويف وتلاوة آيات العذاب عليهم من غير بيان الأحكام والتكاليف، لعدم ترتّب ثمرةٍ وفائدةٍ على هذا الإنذار، بل المراد من الإنذار تبليغ الأحكام وتعليم الناس، وتذكيرهم بأنّهم لم يخلقوا عبثاً ولم يهملوا كالبهائم، وأنّ الله تعالى جعل عليهم _ لحفظ مصالحهم ووصولهم إلى مقام الكمال _ تكاليف في جميع اُمورهم، وبيان ما يجب عليهم وما يحرم، وما يهديهم إلى طريق الرشد والكمال ويبعّدهم عن الغيّ والضلال، وهذا هو المراد من الإنذار المذكور في قوله تعالى: ﴿وَاُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القُرآنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾،((2)) وفي قوله عزّ اسمه: ﴿وَلِتُنْذِرَاُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾؛((3)) فإنّ المراد من إنزال القرآن ليس مجرّد إنذار القوم ومن بلغ واُمّ القرى ومن حولها بتلاوة آيات العذاب والعقاب، بل الإنذار بهذا المعنى إنّما يكون من توابع تبليغ المعارف والأحكام وتنبيه الناس وسوقهم إلى
ص: 149
سبيل الكمال، لعدم ارتداع أكثر الناس عن المعاصي والسيّئات بمجرّد النهي وعدم قيامهم بأداء الواجبات والحسنات بمجرد الأمر، فلابدّ من الإنذار والتوعيد بالعقاب والعذاب على المخالفة والعصيان، هذا.
وأيضا لا يخفى عليك: أنّ المراد بالحذر ليس مجرّد التخوّف والتحذّر القلبي، بل المراد منه هو التحذّر في العمل. هذا ما يستفاد من ظاهر الآية بحسب العرف وما يفهم أهل اللسان.
وربما تفسّر الآية الشريفة على نحوٍ آخر((1)) وهو: أنّ رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كان إذا خرج غازياً لم يتخلف عنه إلّا المنافقون والمعذرون، فلمّا أنزل الله تعالى عيوب المنافقين وبين نفاقهم في غزوة تبوك، قال المؤمنون: والله لا نتخلف عن غَزاة يغزوها رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ولا سرية أبداً، فلمّا أرسل رسول الله السرايا إلى الغزو نفر المسلمون جميعاً وتركوا رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وحده، فأنزل الله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ الْ_مُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً...﴾.((2)) الآية.
وهذا التفسير خلاف ظاهر الآية الشريفة وإنّما فس_رت به اهتماماً بحفظ وحدة السياق. والدليل على كونه خلاف الظاهر: أنّ المستفاد من قوله: ﴿وَمَا كَانَ الْ_مُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا﴾((3)) هو النفي، وأنّه ليس لهم أهلية النفر كافة وشأنية ذلك، أو ليس لهم كافّةً قصد ذلك على قول بعض أهل الأدب، ولا يستفاد منها النهي، فإنّ النهي يستفاد من أمثال المقام إذا دخلت اللام على المنهيّ، كقوله عزَّ من قائل: ﴿مَا كَانَ لِأهْلِ الْ_مَدينَةِ
ص: 150
وَمَنْ حَوْلَ_هُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ الله﴾،((1)) وأمّا إذا دخلت على الفعل مثل هذه الآية ومثل: ﴿مَا كَانَ الله ُ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾((2)) و ﴿مَا كَانَ الله ُ لِيَذَرَ الْ_مُؤْمِنينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾((3)) و﴿لَمْ يَكُنِ اللّٰه ُ لِيَغْفِرَ لَ_هُمْ﴾((4)) فتدلّ على النفي.
هذا مضافاً إلى أنّ المستفاد من قوله تعالى: ﴿فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ هو الترغيب والتحريص على النفر، وعلى هذا التفسير لا يبقى مجال للترغيب، كما لا يخفى.
والحاصل: يرد على هذا التفسير أوّلاً: أنّه خلاف ما يستفاد من ظاهر جملة: ﴿وَمَا كَانَ الْ_مُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾، حيث إنّ المستفاد منها النفي وعدم كون المؤمنين أهلاً لأن ينفروا كافّةً لكونه سبباً لاختلال النظام.
وثانياً: أنّه مخالفٌ لما يستفاد من جملة: ﴿فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٍ﴾
وهو كون المتکلّم في مقام التحريص والترغيب إلى النفر. مع أنّه لا معنى للفظة «لولا» التحضيضية بمقتضى هذا التفسير.
وثالثاً: يلزم أن يكون الضمير في قوله: «ليتفقّهوا» و«لينذروا» راجعاً إلى غير المذكورين في الكلام وهم المتخلّفون.
ورابعاً: هذا التفسير لا يخلو من الاعوجاج وعدم الاستقامة، ومن كان له اُنسٌ بكلام الله تعالى وبلاغته في بيان المطالب والمقاصد يعرف مرجوحية هذا التفسير.
هذا مع أنّ الأمر ليس خارجاً كذلك، فإنّ التاريخ الإسلامي محفوظٌ ومضبوطٌ بحمد الله تعالى ولم يكن الحال كما ذكر، حتى أنّ في الغزوات لم يكن المؤمنون نافرين
ص: 151
للجهاد جميعاً بل ربما يتسامح كثيرٌ منهم في أمر الجهاد، ولهذا كثر نزول الآيات في ترغيبهم إلى الجهاد وذمّ المتقاعدين عنه، فضلاً عن الس_رايا الّتي لم يكن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ليخرج إلى الجهاد معها.
هذا مضافاً إلى أنّ أمر الجهاد ليس أمراً من الاُمور العادية بل كان من الاُمور المهمّة، وتجهيز الجيوش والعساكر وتنظيم أمر المجاهدين لم يكن إلّا بأمر النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، وما كان أمراً يعمل فيه کلّ أحدٍ على رأيه وسليقته ومن غير استئذان عن رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ).
وبالجملة: فهذا التفسير ممّا يمكن دعوى القطع على خلافه.
وأمّا ما قيل في تفسير الآية بوجهٍ آخر وهو: أنّ المراد تحريض المؤمنين على أن ينفر من کلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ للجهاد ليتفقّهوا في الدين، أي: ليروا آيات الله تعالى في غلبة المسلمين على أعدائه، ونصرته إيّاهم عليهم.
أو ليتفقّهوا في الدين، أي: يتعلّمون من النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أحكام الدين حتى ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
فهو أيضاً خلاف الظاهر؛ لأنّ الغاية في الآية هي التفقّه في الدين، وعلى هذا التفسير تكون غايته الجهاد مع الأعداء.
فما هو الظاهر ليس إلّا التفسير الأوّل، والله هو العالم.
ثم إنّه ينبغي الإشارة إلى نكتة وهي: أنّه قد قلنا بأنّ المراد من الإنذار ليس مجرّد الإيعاد بالعقاب، بل المراد منه هو التبليغ والتعليم وبيان الأحكام الشرعية، وإنّما عبّر عنه بالإنذار ليكون أوقع في النفوس، فاعلم: أنّ ذلك يتصوّر على ثلاثة أوجه:
ص: 152
أحدها: بنحو التذكير وهو شغل الوعّاظ، فإنّ الوعظ عبارة عن: تنبيه الناس بما هو مركوزٌ في أذهانهم ومعلومٌ لهم ولكنّهم غفلوا عنه وصرفت الاشتغالات الدنيوية توجّههم عنه، فالواعظ يتعلّم المطالب الّتي كانت من هذا القبيل ويعلّم الناس ويذكّرهم إذا جلس على كرسيّ الوعظ والإرشاد.
ثانيها: تعليم الفقيه وتبليغه، وهو ليس إلّا بيان نتيجة ما تعلّمه وإظهار رأيه وما استقرّ عليه نظره في مقام الاجتهاد والحكم الشرعي، ولا يكون حجّة إلّا لمن يقلّده.
ثالثها: نقل الحديث من غير أن يكون نظر الناقل إلى بيان رأي نفسه. وهذا تارة: يكون نقل الحديث بألفاظه من غير تصرّفٍ فيها سواءً علم مضمون ما ينقله أم لا. وتارة: يكون نقلاً بالمعني، بمعنى أن لا يكون مراده نقل ألفاظ الإمام بل نقل معنى ما سمعه منه بنحو كان نقله هذا مفهماً ومفيداً لما قاله الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بألفاظه. هذا تمام الكلام فيما هو راجع إلى تفسير الآية.
وأمّا الكلام في بيان الاستدلال بالآية على حجّية خبر الواحد، فنقول:
استدلّ على حجّية الخبر بالآية الش_ريفة بتقريب: أنّ مقتض_ى کلمة «لولا» التحضيضية وجوب النفر لتعلّم الأحكام والتفقّه في الدين ووجوب تبليغ الأحكام وإنذار الناس ووجوب التحذّر والعمل بالأحكام عند التبليغ مطلقاً؛ لإطلاق وجوب الإنذار وعدم كونه مقيّداً بإفادته للعلم، وإطلاق کلمة «طائفة» وعدم تقييدها بجمع يكون تواطؤهم على الكذب محالاً عقلاً أو عادة، ولإفادة قوله: «لينذروا» وجوب الإنذار على کلّ واحد من النافرين بما هو هو لا بما أنّه أحد النافرين _ الّذين يوجب إخبار جميعهم العلم بالمخبر به _ لعدم معهودية ذلك،
ص: 153
ولوضوح أنّ المراد ليس وجوب الإنذار على کلّ واحد بما أنّه أحد الجميع، بل بما أنّه منذر ومبلّغ، كما لا يخفى.((1))
استشكل الشيخ(قدس سره) على الاستدلال بالآية بوجوه:
أحدها: يرجع إلى الشكّ في شمول الآية إذا كان المنذر واحداً، فيمكن أن يكون وجوب التحذّر متوقّفاً على حصول العلم وليس في الآية إطلاقٌ يثبت به وجوب الحذر مطلقاً.
ثانيها: راجعٌ إلى عدم شمول الآية لما استدلّوا بها على حجّيته وهو خبر الواحد بتقريب: أنّ الآية إنّما تكون مسوقة لبيان وجوب التفقّه وتعلّم أحكام الله تعالى والاُمور الدينية الواقعية والتحريض على التعلم والتعليم لحفظ أحكام الله الواقعية عن المهجورية وإخراجها من زاوية الخمول والمستورية والمجهولية، فلا تدلّ على أزيد من وجوب الحذر عقيب الإنذار بهذه الاُمور الدينية الواقعية، ومع عدم العلم بأنّ الإنذار هل وقع بهذه الاُمور أو بغيرها خطأً أو عمداً من المنذر (بالكس_ر) لا يجب الحذر، فينحص_ر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذَر صدق المنذِر في إخباره عن أحكام الله تعالى.
ثالثها: أنّه لو سلم دلالة الآية على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين ولو لم يفد العلم، لكنّه يمكن منع دلالتها على وجوب العمل بالخبر من حيث إنّه خبر ووجوب الحذر عند نقل الراوي ومن يتحمّل الحديث والرواية، فإنّه من الممكن أن يكون وجوب الحذر عقيب إنذار الوعّاظ لكون الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف وهو من
ص: 154
شأن الوعّاظ لا الرواة والمحدّثين، فتكون الآية مسوقةً لبيان إلزام التعلّم والتفقّه وما يتوقّف عليه أداء شغل الوعظ بين الناس من تعلّم الأحكام والآيات وكلّ ما يرتبط بالاُمور الدينية ووجوب الإرشاد والتنبيه والتذكير، ووجوب الحذر والاتّعاظ عند وعظ الوعّاظ، أو عقيب بيان حكم الله تعالى بنحو الإفتاء وأنّه ذات حكم الله تعالى لا أنّه خبرٌ كما هو شأن الفقيه، ويدلّ عليه قوله عزّ اسمه: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدّينِ﴾،((1)) فإنّ التفقّه عبارة عن: تعلّم أحكام الله وحقيقة التكاليف والوظائف ال_شرعية. فعلى هذا، يكون الحذر واجباً على المقلّد دون غيره، وتكون الآية مسوقة لبيان وجوب التفقّه وتعلّم الأحكام والإفتاء ووجوب قبوله على المقلّدين، هذا...((2))
ويمكن الجواب عن الإشكال الثالث: بأنّ التزام كون الآية في مقام إلزام الوعظ والاتعاظ؛ بعيدٌ للغاية.
وأمّا كونها في مقام بيان وجوب تحصيل الأحكام على نحو هو من شأن الفقيه.
ففيه: أنّه ليس ما بين شأن الفقيه وشأن نقلة الأخبار في زمن النبيّ والأئمّة _ صلوات الله عليهم _ كثير فاصلة، وأكثر ما اتّفق في تلك الأزمنة ليس إلّا سماع الأحكام من المعصومين(علیهم السلام) ونقل قولهم إلى الغير للعمل به. نعم، ربما كان بين نقلة الأخبار من كان عالماً بحقائق الأحكام كما هو شأن الفقيه في ذلك الزمان. ولذا ربما نرى أنّ رجلاً سأل من الإمام حكماً وسمع جوابه عنه، ولكن بعد نقله هذا الحديث إلى من له بصيرة بعلوم أهل البيت وفقههم لا يعمل به ويقول بأنّه أعطاه من جراب النورة، والإمام أيضاً يصدّقهم في هذا العمل، كما ورد في من سأل عن حكم إرث البنت إذا كان للميّت أخ، وجواب الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بتنصيف تركته، وردّ الأصحاب ذلك
ص: 155
وأنّ الإمام أعطاه من جراب النورة وأنّ الحكم كون تمام المال للبنت، وبعد أخذه بذلك وردّ تمام المال إلى البنت سأل عن الإمام فأجابه بصحّة ما قالوه.((1))
والحاصل: أنّه ليس في تلك الأزمنة كثير فرق بين ناقل الأخبار والفقيه، كما هو الحال في زماننا، لأنّ في زماننا بواسطة بعده عن عصور الأئمّة الطاهرين(علیهم السلام) لابدّ في فهم الأحكام من الاطّلاع على علم الرجال واُصول الفقه والدراية وغيرها، وصار هذا الاحتياج سبباً لكون الفقيه باصطلاحنا غير المحدّث، فإنّ الثاني ربما يكون محتاجاً إلى الأوّل في تعلّم الأحكام والرجوع إليه في مقام التقليد، بخلاف زمان الأئمة(علیهم السلام)، فإنّ كثيراً مّا يطلق على المحدّثين ونقلة الأخبار لفظ الفقهاء، وكان من ينفر إلى الإمام ويسأله عن المسائل العامّة الابتلاء مرجعاً لغيره، لكن لا على نحو المتداول في زماننا في مرجعية الفقهاء، بل بما أنّه ناقل لرأي الإمام وحاكٍ لِما سمع منه، فكان شأنهم شأن نقلة الفتوى في زماننا هذا.
ولقائل أن يقول: إنّ المستفاد من الآية الشريفة ربما يكون وجوب تحصيل العلم بالأحكام أزيد من ذلك، فإنّ التفقّه ليس شأن نقلة الأخبار والمحدّثين ولا يطلقون عنوان الفقيه عليهم حتى في أزمنة الأئمّة(علیهم السلام)، بل المراد بالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية وحقائقها.
فالّذي ينبغي أن يقال: إنّ تحمّل الحديث يكون على أنحاء:
أحدها: تحمّل خصوص الألفاظ بسماعها عن أحد من غير فرقٍ بين أن يكون المتحمّل ممّن يرى حجّية قول من تحمّل عنه، أو لم يكن كذلك؛ ومن غير فرق بين أن يفهم للكلام الّذي يتحمّله ظهور في العرف، أو يعرف حجّية ظهوره إذا كان عالماً
ص: 156
بظهوره العرفي، وبين أن لا يفهم ذلك؛ ومن غير فرق بين أن يكون عارفا بكون ما يحمله أو يتحمّله عامّاً بالنسبة إلى غيره أو خاصّاً، فلا يكون في البين إلّا مجرّد نقل الألفاظ.
ثانيها: أن يكون نقلاً بالمعنى بأن يكون الّذي يتحمّل الحديث ممّن يفهم مراد المتکلّم من کلامه وعالماً بحجّية ظهوره العرفي، وكان غرضه من تحمّل الحديث إفادة معناه وما استفاده من ظاهر الكلام بحسب الظهور العرفي من غير أن يكون کلام من يتحمّل عنه حجّة عنده.
ثالثها: أن يكون الحامل للحديث حاملاً له بأن يراه حجّة ويعرف ما كان عامّاً أو خاصّاً أو مطلقاً أو مقيّداً بالنسبة إليه، وكان غرضه من نقل الحديث إفادة معناه وما هو عقيدة من تحمّل عنه، فهو وإن كان ربما ينقل الحديث بألفاظٍ سمعها إلّا أنّ نظره إلى نقل معناه وبيان ما هو رأي غيره وعقيدته دون الألفاظ.
والظاهر أنّ القسمين الأوّلين ليسا من التفقّه وإن كان ربما يعتنى بهما أيضاً كثير اعتناء خصوصاً في الأزمنة السالفة، فإنّه كان لأمثال هولاء المحدّثين شأنٌ عظيمٌ بين الناس، وكانت لهم مكانةٌ عظيمةٌ، حتى أنّ مثل المأمون _ الخليفة العباسي _ حينما ورد سفيان بن حرب _ أحد المحدّثين _ ببغداد _ كما في تاريخ بغداد _ جعله مورداً للاحترام والتكريم، وأمر بعقد مجلس قرب دار الخلافة لأن يملي الرجل الحديث، وكان يجتمع عليه جماعات كثيرة لأخذ الحديث بحيث احتاج إلى عدّة من المستملين، والمأمون نفسه أيضاً يستمع الحديث في مكانه المخصوص.((1))
وكيف كان، يعدّ هذا القسم من تحمّل الحديث من الشؤون المهمّة، ولا مانع من
ص: 157
القول بشمول حديث: «من حفظ على اُمّتي أربعين حديثاً»((1)) له، إلّا أنّه مع ذلك ليس هذا القسم من تحمّل الحديث تفقّهاً ولا إنذاراً.
وأمّا القسم الثالث، فهو داخل في التفقّه ويطلق على متحمّله الفقيه وتشمله الآية الشريفة.
فإنّ التفقّه وتعلّم الأحكام في الصدر الأوّل كان بالنسبة إلى زماننا في غاية السهولة. فإنّ من يتشّرف بالحضور عند النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) مثلاً ويسمع منه الأحكام أوّلاً لا يحتاج إلى علم الرجال وملاحظة حال الرواة ونقلة الحديث. وثانياً بواسطة حضوره في مجلس الإمام ووجود القرائن الحالية والمقالية ربما لا يشكّ في جهة صدور قول الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) وأنّ الكلام صدر لبيان حكم الله الواقعي أو غيره، أو أنّه هل يكون لهذا الكلام معارضٌ أو خاصٌّ أو مقيّد أم لا، حتى يحتاج إلى الفحص من الأدلّة وبعد الفحص وعدم الظفر يعمل بمقتض_ى الأصل من الحكم بعدم وجود المعارض أو عدم كونه في مقام التقيّة مثلاً، ومع الشكّ أيضاً لا يحتاج إلى إتعاب النفس والتفحّص لحضور الإمام عنده وإمكان السؤال منه غالباً. وثالثاً: لا يخفى عليك: أنّ الفقه في زماننا هذا قد بلغ مدارجه وحاز مكانه اللائق به من الدقّة والمتانة ونهاية الاستحكام، وحيث لم يكمل في الصدر الأوّل ولم يدرج مدارجه ربما لا يحتمل في الألفاظ الصادرة من الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) من إطلاقها وتقييدها وعمومها وخصوصها وظاهرها وأظهرها ما نحتمله، ولا يصير الكلام مورداً للدقة وكمال العناية به، ولا ملاحظة جميع الجهات الراجعة إلى الكلام كما يلاحظ في زماننا، فإنّ لملاحظة هذه الجهات دخلاً كثيراً في فهم الروايات واستنباط الأحكام، وحيث كان الفقه في زمانهم في مراتبه الأوّلية ربما لم ينقدح في أذهان كثيرٍ من الفقهاء ما ينقدح في أذهان من تأخّر عنهم.
ص: 158
وبالجملة: فالفقيه بالنسبة إلى کلّ زمان بحسب هذه الملاحظات ربما يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره في غير هذا الزمان. وهذا ليس سبباً لعدم كون من يتحمّل الحديث على النحو الثالث من الفقهاء؛ لأنّ الفقه في تلك الأزمنة ليس إلّا هذا. وإن شئت فقل: إنّ هذا النحو من تحمّل الحديث اجتهادٌ صغيرٌ سهلٌ.
إذا عرفت ذلك تعلم: أنّ الآية إنّما تدلّ على وجوب النفر للتفقّه في الدين على أهل کلّ زمانٍ بحسب حالهم، ووجوب الإفتاء والإنذار على الفقهاء، والتحذّر العملي وقبول رأيهم على غيرهم.
وأمّا وجوب تحمّل الحديث على النحو الأوّل والثاني فليس المراد من الآية ظاهراً.
وبالجملة: فرقٌ بين المحدّث الّذي شغله تحمّل الحديث والتحديث، وبين المجتهد والمفتي والفقيه الّذي من شأنه الإفتاء.
فإنّ الأوّل ربما يتحمّل الحديث ويحدّث بما تحملّه من غير أن يعتقد حجّية کلام المتکلّم، بل ومن غير أن يكون عالماً بمفاد ما يخبر به بحسب المتفاهم العرفي وإنّما ينقل ما سمعه من غيره، ولذا لو سئل عن حجّية کلّامه لغيره فليس له أن يجيب بحجّيته، ولا يكون مخبراً عن اعتقاده ورأيه في نقله وإخباره. وأيضا المحدّث بعد التحديث لو مات أو زال عقله لا يضرّ ذلك بما حدّثه، ولا تزول حجّية حديثه وخبره بما أنّه خبرٌ وحديثٌ.
بخلاف المجتهد والمفتي والفقيه، فإنّه يخبر عن عقيدته ورأيه. ولو حدّث بحديث فيحدّث به بما أنّه مستند رأيه وعقيدته، ولذا لو سئل عن حجّيته يجيب بكونه هكذا. وأيضاً المجتهد والفقيه إذا مات أو تبدّل رأيه أو اختلّ عقله تزول آثار فتواه ولا يجوز الأخذ بفتواه وعقيدته، فإنّها تزول بموته أو غيره من أسباب زوالها، ولا دليل على حجّيتها لمقلّديه بعد زوالها، ولا على بقائها بعد موته لعدم معلومية كيفيات ما بعد الموت وتفصيلاته، ولذا نرى في مسألة الإجماع اتّفقوا على كفاية إجماع العلماء في عص_رٍ
ص: 159
واحدٍ لعدم احتسابهم آراء الأموات رأياً واعتقاداً لهم بعد الموت، فلا يعتبرون لموافقة آرائهم مع آراء الأحياء دخلاً في تحقّق الإجماع، ولا يعتنون بمخالفتهم.((1))
والحاصل: أنّ المحدّث غير المفتي، والتحديث ونقل الخبر غير الإفتاء. نعم، لا مانع من اجتماعهما في مورد واحدٍ، كما إذا أخبر فقيهٌ في مقام نقل رأيه وفتواه بخبرٍ يرويه عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولكن كثيراً مّا يتّفق انفكاكهما عن بعضهما، كما لا يخفى.
فتلخّص من جميع ما ذكر: أنّ الصواب ذكر الآية الش_ريفة في مباحث الاجتهاد والتقليد دون مبحث حجّية خبر الواحد، لعدم ارتباطها بحجّية الخبر من حيث إنّه خبرٌ، فافهم وتأمّل.
وأمّا الإشكال على الاستدلال بالآية بمنع إطلاقها في وجوب التحذّر إمّا من جهة أنّ القدر المتيقّن ممّا يستفاد من الآية وجوب التحذّر في الجملة. وأمّا إطلاقه بحيث يشمل وجوبه ولو لم يكن الإنذار مفيداً للعلم فمحلّ تأمّلٍ، بل منعٍ. وإمّا من جهة أنّ الآية مسوقة لأجل التوطئة والتمهيد لتعليم الأحكام وتبليغها ونشرها ووجوب بيانها صوناً لوقوع التعطيل في الشريعة سواءٌ كان مفيداً للعلم أم لا. ولا يستفاد منها غير التحريض على إخراج أحكام الله الواقعية من حجاب الاستتار وتفقّهها وإنذارها ووجوب التحذّر عند الإنذار والإبلاغ إذا كان ما يبلّغه المبلّغ والمنذِر من الأحكام الواقعية.
ففي الحقيقة تكون الآية متكفّلة للترغيب في كون بعض الناس واسطة بين المعصوم وسائر الناس في بيان الأحكام، ومؤدّياً لما هو وظيفته. ولا ملازمة بين هذا ووجوب التحذّر مطلقاً عند تبليغ کلّ مبلّغٍ وحجّية قوله ولو لم يكن مخبراً عن الأحكام الواقعية. فعلى هذا، يقيّد وجوب التحذّر بصورة إفادة العلم ليس إلّا.
ص: 160
ففيه: أنّ الآية مسوقة للتسبيب إلى التفقّه وتعلّم الأحكام، ووجوب الإبلاغ والإنذار والحذر العملي، والتحريض على نفر طائفةٍ من کلّ فرقةٍ ليتفقّهوا في الدين، والتفقّه في الدين أمر يقتضي نفر الجميع له إلّا أنّ امتناعه عادةً ولزوم اختلال النظام من وجوب النفر على الجميع منع من ذلك وصار موجباً لوجوب نفر البعض على سبيل الكفاية.
ولا يتمّ منع إطلاقها إلّا بالتصرّف في ظاهرها إمّا بتقييد الطائفة على جماعةٍ كثيرةٍ لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادةً، وهو كما ترى. أو تقييد وجوب الحذر بصورة حصول العلم بما ينذر، وهو مستلزم لنقض الغرض والوقوع في المفسدة الّتي أوجب دفعها تخصيص وجوب التفقّه بالبعض مع وجود المقتضي لوجوبه على الجميع؛ فإنّ الغرض _ من النفر والترغيب إليه ووجوبه كفايةً على البعض لأجل وجود المانع عن وجوبه العيني على الكلّ _ هو التفقّه في الدين وتبليغ الأحكام إلى المتخلّفين الّذين لم يتمكّنوا من النفر لأجل إخلاله بوضع معاشهم ونظم امورهم، وعلى هذا لو كان وجوب التحذّر مقيّداً بصورة العلم يكون منافياً لإطلاق الطائفة الصادقة على الواحد فما زاد.
وربما لا يتّفق عدم احتمال الخلاف في إخبار المنذر، وعليه فإمّا أن يجب على المنذر (بالفتح) القبول أم لا، وعلى الثاني، فإمّا أن لا يجب عليه تحصيل العلم مقدّمةً للتحذّر العملي وإمّا أن يجب، ولا سبيل إلى الأوّل، وعلى الثاني فليس له طريقٌ إلّا نفر کلّ واحدٍ من المکلّفين وتفقّههم، وهو مستلزم لنقض الغرض واختلال اُمورهم الاجتماعية.
لا يقال: إنّ من الممكن تحصيل العلم بإخبار جماعة من النافرين.
فإنّه يقال: ليس امتناعه عادةً وإخلاله بالنظام بالنسبة إلى جميع المتخلّفين أقلّ مرتبةً من تطرّق ذلك في نفرهم؛ لعدم كونهم غالباً بهذه الكثرة، وعدم إمكان الاطّلاع على رأي جميعهم غالباً.
ص: 161
فإن قلت: يمكن منع الإطلاق بالروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة، كصحيحة يعقوب بن شعيب، وعبد الأعلى، ومحمد بن مسلم الدالّة على وجوب النفر لمعرفة الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) مع الاستشهاد لوجوبه بالآية الشريفة.((1))
وجه المنع: أنّ معرفة الإمام ليست ممّا يكتفى فيه بغير العلم وما يفيد الظنّ بل هي مقيّدة بالعلم، ومقتضى ذلك كون الآية في مقام وجوب النفر للتفقّه والإنذار بعد الرجوع ووجوب التحذّر في الجملة، والقدر المتيقّن منه وجوبه إذا أفاد العلم.
قلت:((2))
لا يخفى عليك: أنّهم استدلّوا بالآية الشريفة تارةً: بأنّ کلمة «لعلّ» حيث يمتنع استعمالها في معناها الحقيقي وهو الترجّي لامتناعه في حقّه تعالى، فهي ظاهرةٌ في كون مدخولها محبوباً للمتكلّم، وأنّها استعملت في طلب الحذر.
وفيه: أنّ استعمال «لعلّ» في الطلب أو بداعي الطلب هنا خلاف البلاغة؛ فإنّه عدولٌ عمّا يقتضيه سياق الكلام ويناسب المقام، فإنّ الآية إنّما تكون في مقام إفادة وجوب النفر وترتّب التفقّه عليه، وبيان كون التفقّه لتحذّر نفس المتفقّهين غاية له، وأنّ الإنذار غاية للتفقه لحصول التحذّر للمنذرين (بالفتح)، وكون التحذّر غاية
ص: 162
للإنذار؛ ولو قيل بكونها في مقام جعل الوجوب والإلزام وطلب التحذّر بعد قوله: ﴿إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ يلزم منه قطع سياق الكلام، كما لا يخفى.
إن قلت: إذا لم يكن هذا معناها فما هو المستعمل فيه کلّمة «لعل» في المقام مع أنّها بمعناها الحقيقي وهو الترجّي محالٌ في حقّه تعالى؟
قلت: إنّما تستعمل کلّمة «لعلّ» لإفادة ترتّب مدخولها على غيره ممّا يكون مذكوراً قبلها وكونه في معرضية الترتّب والحصول، وحيث إنّ جميع الناس لا يحذرون بل بعضهم يحذر وبعضهم لا يحذر يكون الحذر عند الإنذار في معرض الحصول وعدمه. ولا يجب أن يستعمل اللفظ في الترجّي الّذي يكون مستعمله جاهلاً بوقوع الش_يء المترجّى، بل يكفي كونه في معرضية الترتّب والحصول وإن كان المتکلّم يعرف من يحذر ومن لا يحذر بعينه ولا يكون جاهلاً بالحال.
وتارة اُخرى: استدلوا بأنّ الإنذار واجب لكونه غاية للنفر الواجب، وإذا ثبت وجوبه وجب التحذّر وإلّا يلزم لغوية وجوب الإنذار.
وأجاب في الكفاية عن هذا الوجه: بعدم انحصار فائدة الإنذار بوجوب التحذّر مطلقاً حتى يلزم اللغوية، بل يمكن تقيّده بصورة إفادة الإنذار العلم لو لم نقل بكونه مشروطاً به.((1))
والحقّ في الجواب أن يقال: إنّ وجوب التحذّر الّذي توهّم كونه غايةً للواجب أو لوجوبه إمّا أن يكون حكماً ظاهرياً أو حكماً واقعياً، فإن كان حكماً ظاهرياً، ففيه: _ مضافاً إلى أنّ ظاهر الآية كون الحذر غايةً لوجوب الإنذار أو الإنذار نفسه، لا وجوب الحذر _ أنّ وجوب الحذر ليس ممّا يترتّب على وجوب الإنذار، لأنّهما في عرضٍ واحدٍ. وإن كان المراد كونه غايةً للإنذار، فوجوب الحذر ليس ممّا وقع غايةً له ويترتّب عليه.
ص: 163
و أمّا إن كان حكماً واقعياً، ففيه: أنّ الوجوب الواقعي للحذر ليس غايةً لوجوب الإنذار أو الإنذار نفسه، بل هو ممّا يترتّب على وجوب الأحكام الثابتة والواقعية ليس إلّا، لا على وجوب الإنذار.
وثالثة: يستدلّ بها بأنّ الحذر وقع في الآية غايةً للنفر الواجب، والغاية المترتّبة على فعل الواجب مطلوبة للشارع وواجبةٌ شرعاً.
لا يقال: إنّ الإنذار يجب أن يكون بالأحكام الواقعية، والحذر والعمل أيضاً إنّما يجب إذا كان الإنذار بها.
فإنّه يقال: تقييد وجوب العمل بالعلم بكون الإنذار بالأحكام الواقعية موجب لنقض الغرض، كما مرّ ذكره.((1))
ثم إنّه لا يخفى عليك الفرق بين ما قلنا في وجه عدم دلالة الآية على حجّية الخبر بما هو خبر وكونها في مقام حجّية الفتوى، وبين ما أفاده الشيخ(قدس سره) وغيره في وجه ذلك. فإنّ جهة إشكالنا راجعةٌ إلى ما يستظهر من لفظ التفقّه، وعدم شموله لمجرّد نقل الخبر والحديث. وجهة إشكاله راجعة إلى ما يستفاد من لفظي الإنذار والحذر، وأنّ المحدّثين والمخبرين ليس شأنهم الإنذار، وليس مقام حديثهم مقام الحذر.
ولكن فيه: أنّ منشأ هذا التوهم حسبان أنّ المراد من الإنذار هو: التهديد والتوعيد والتخويف، ومن الحذر: التخوّف القلبي، مع أنّه بمكان من الضعف والفساد، كما مرّ((2)). فإنّ المراد من الإنذار في المقام هو الإبلاغ، كما هو المراد من قوله سبحانه: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَ_خَافُونَ أَنْ يُ_حْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ﴾،((3)) وقوله عزّ من قائل: ﴿وَاُوحِيَ
ص: 164
إِلَيَّ هَذَا الْقُرآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾.((1)) والمراد من الحذر هو العمل على وفق الإبلاغ لا مجرّد التخوّف القلبي، والله هو العالم.
من الأدلّة الّتي تمسّكوا بها لإثبات حجّية خبر الواحد، السنّة.
وليعلم: أنّ ما يظهر من اُصول الشافعي المسمّى بالرسالة تمسّكه لحجّية خبر الواحد بالسنّة فقط، ولم يذكر الآيات من الأدلّة أصلاً. ويظهر من ذلك أنّ الاستدلال بالآيات لم يكن معهوداً بينهم في الصدر الأوّل، فلا مجال لاستنكار إنكار تمامية الاستدلال بالآيات لكونه إنكاراً لما تمسّك به الأوائل لحجّية خبر الواحد. وعلى کلّ حال، فلا يجب علينا إلّا متابعة الدليل، فلو لم يتمّ الاستدلال بالآيات فليس لنا أن نلتزم بتماميته، ذكرها القدماء من جملة الأدلّة أم لم يذكروها.
ولا يخفى عليك: أنّ تمسّكه بالروايات إن كان بأخبار الآحاد بحيث كان دليله على حجّية خبر الواحد هو خبر الواحد نفسه، فلا إشكال في فساده واستحالته. وإن كان استدلاله بها من باب دعوى تواترها، فإمّا يراد منه التواتر اللفظي أو المعنويّ أو الإجماليّ.
فإن اُريد بالتواتر في المقام التواتر اللفظي؛ فلا إشكال في عدم تحقّق هذا التواتر، ومن ادّعاه فلا تسمع دعواه، لأنّه لا يوجد لفظ دالّ على حجّية الخبر متواتراً بأن أخبر جماعة _ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب _ بصدور هذا اللفظ الدالّ على هذا المعنى من المعصوم(عَلَيْهِ السَّلاَمُ).
وإن اُريد به التواتر المعنوي بأن أخبر جماعةٌ _ يمتنع تواطؤهم على الكذب عادةً _
ص: 165
عن المعصوم بحجية خبر الواحد، لكن لا بلفظٍ واحدٍ بل بألفاظٍ مختلفةٍ بحيث كان غرضهم من إخبارهم بذلك مجرّد نقل حجّية خبر الواحد عن المعصوم من دون عناية باللفظ الصادر منه؛ فهو أيضاً غير متحقّق في المقام قطعاً.
وإن كان المراد من دعوى التواتر دعوى التواتر الإجمالي، كأن يدّعى دلالة الروايات الكثيرة الواردة في الموارد المختلفة _ الّتي تكون بحيث يمتنع تواطؤ رواة کلّ واحدة منها على الكذب، ويقطع بصدق واحدة منها _ على حجّية خبر الواحد بالالتزام، بأن كان لازم جميع هذه الروايات المختلفة حجّية خبر الواحد؛ فهو ممّا ينبغي الاعتناء به ويصغى إليه وإن كان على مدّعيه إثباته.
فعلى هذا، لا يتمّ الاستدلال بالأخبار على حجّية خبر الواحد إلّا إذا ثبت تواترها الإجمالي.
ولا يخفى عليك: أنّ لدعوى ذلك مجالاً إذا كان المدّعي من الإمامية لسعة دائرة السنّة عندنا، فإنّها عبارة عن قول النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم وفعلهم وتقريرهم، بخلاف العامّة، فإنّهم جعلوا أنفسهم _ من هذه الجهة _ في ضيقٍ وتركوا الرجوع إلى العترة _ الّتي اُمروا بالرجوع إليها _ فالسنّة عندهم عبارةٌ عن قول النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وفعله وتقريره.
وإذ قد عرفت ذلك، فاعلم: أنّ ما يظهر من الشيخ(قدس سره) في رسائله هو التمسّك لحجّية الخبر بطوائف أربع من الروايات:
الاُولى: بعض ما ورد في الخبرين المتعارضين المسمّى بالأخبار العلاجية مثل: ما رواه صاحب عوالي اللئالي.((1))
الثانية: ما يستفاد منه إرجاع بعض الناس إلى بعض الرواة مثل: زرارة، ومحمد بن
ص: 166
مسلم، وأبي بصير، وغيرهم.
الثالثة: ما يستفاد منه الإرجاع إلى الرواة بطريق العموم لا إلى أشخاص معيّنين. فالفرق بين هذه الطائفة والطائفة الثانية أنّ في الثانية اُمروا بالرجوع إلى أشخاص معيّنين بخلاف الطائفة الثالثة.
الرابعة: بعض الأخبار الدالّة على الأمر بأخذ الأخبار أو كتابتها وغير ذلك؛ فإنّه يستفاد منها وجوب الأخذ بما يرويه الراوي أو ما كتبه أحد الرواة، لأنّ فائدة حفظ الروايات وكتابتها ليس إلّا الأخذ بها.
وقد أفاد الشيخ(قدس سره) بأنّه وإن لم يمكن الاستدلال بكلّ فردٍ فردٍ من هذه الروايات إلّا أنّه يمكن الاستدلال بمجموعها.((1))
وفيه: أنّ المجموع ليس إلّا الأفراد، فإن لم تكن الأفراد قابلة لأن يستدلّ بها فكيف يكون المجموع قابلاً له؟ هذا.
ويمكن أن يزاد على الطوائف الّتي ذكرها الشيخ(قدس سره) من الأخبار طوائف اُخرى:
إحداها: الروايات الواردة في احتجاجات الأئمّة(علیهم السلام) مع علماء المخالفين في باب القضاء.((2))
ثانيتها: الروايات الدالّة على أنّ الأئمّة(علیهم السلام) يبعثون بعضاً من خواصّهم أو أصحابهم لتبليغ الأحكام وبيان الفتاوى.((3))
ثالثتها: الروايات الدالّة على أنّ الشيعة يبعثون رجلاً من بينهم للاستفتاء
ص: 167
وسؤال الأحكام عن الأئمّة(علیهم السلام) وأنّهم كانوا يعملون بما يخبرهم من أرسلوه للسؤال عن الأحكام.
رابعتها: الأخبار الدالّة على أنّ أصحاب الأئمّة(علیهم السلام) إذا اختلفوا في مسألة من المسائل واستند الآخذ بأحد طرفي المسألة في مقابل الآخر بروايةٍ يرويها عن المعصوم قبل منه ولا يردّ مختاره في المسألة((1)). نعم، ربما يردّ قوله لعدم إفادة ما رواه لرأيه، ولكن لا يردّون روايته قدحاً في سندها. فتدل هذه الطائفة بالالتزام على إمضاء الأئمّة(علیهم السلام) العمل بخبر الواحد.
وغير هذه الطوائف من الروايات الّتي يطّلع عليها المتتبّع في الروايات في موارد كثيرة. فظهر ممّا ذكرنا صحّة دعوى التواتر الإجمالي في المقام، وإمكان إثبات تواتر هذه الروايات الكثيرة إجمالاً.
من الأدلّة الّتي أقاموها لإثبات حجّية خبر الواحد: الإجماع. ويمكن ادّعاؤه تارة: بقيام إجماع جميع العلماء قولاً على حجّية الخبر. وإجماعهم حجّة من جهة ملازمة ذلك مع المجمع عليه إمّا من جهة العلم بدخول الإمام في المجمعين، وإمّا من جهة قاعدة اللطف، أو الحدس، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه في مبحث الإجماع المنقول.
وتارة: يمكن ادعاؤه بأنّ العلماء أجمعوا على العمل بالخبر. وبعبارة اُخرى: ادّعي
ص: 168
إجماعهم العملي على حجّية الخبر، وبناؤهم على العمل به. والمراد منه إمّا استقرار سيرتهم وبنائهم بما أنّهم علماء، بمعنى أنّ کلّ واحد واحد منهم بما أنّه عالم بحجّية الخبر عامل به، فهو راجع إلى ادّعاء الإجماع القولي. وإمّا أن يكون المراد استقرار سيرتهم بما أنّهم مسلمون، ومعناه كون العمل بالخبر ممّا استقرّ عليه عمل المسلمين دون غيرهم، كالصلوات الخمس في أوقاتها المخصوصة. وإمّا أن يكون المراد به استقرار بنائهم بما أنّهم عقلاء، حتى يكون راجعاً إلى حكم العقل بحجّية خبر الواحد.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ الشيخ قد ذكر في تقرير الإجماع وجوهاً:
أحدها: إجماع العلماء جميعاً _ عدا السيّد وأتباعه _ على حجّية خبر الواحد.
ثانيها: دعوى إجماع العلماء على نحو يكون السيّد وأتباعه داخلين في المجمعين، وتقريره:
إمّا بادّعاء إجماع العلماء على وجوب العمل بالخبر غير العلمي في مثل زماننا هذا وشبهه ممّا انسدّ فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر، فإنّ الظاهر أنّ السيّد إنّما منع عن حجّية الخبر غير العلمي سواء كان في الكتب المعروفة أم لا، لعدم الحاجة إلى مثل هذا الخبر في زمانه لوجود قرائن مفيدة للعلم.((1))
وإمّا بادّعاء حجّية الأخبار المدوّنة في الجوامع المعتبرة ووجوب العمل بها عند الكلّ وإن كانت وجه وجوب العمل بها عند السيّد وابن إدريس احتفافها بالقرائن المفيدة للعلم.
ثالثها: استقرار سيرة المسلمين بما أنّهم مسلمون وإجماعهم على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات، وهذا كاشف عن مطابقة ذلك للواقع قطعاً.
ص: 169
والفرق بينه وبين بناء العقلاء: أنّ السيرة عبارة عن تداول فعل بين المسلمين وإجماعهم على عمل بما أنّهم مسلمون، بحيث يعدّ ذلك ممّا يمتازون به عن غيرهم ويختصّون به دون غيرهم، وذلك علامة مطابقة ما استقرّت سيرتهم عليه مع الواقع قطعاً.
رابعها: دعوى إجماع أصحاب النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) على العمل بخبر الواحد إجماعاً عملياً.
خامسها: استقرار طريقة العقلاء بما أنّهم عقلاء على ذلك، وهو أيضاً كاشف قطعيٌّ عن مطابقة ما استقرّت عليه السيرة مع الواقع.
وقد أفاد في طريق تحصيل الإجماع على الوجه الأوّل بأنّ طريق تحصيله أحد الوجهين على سبيل منع الخلوّ:
أحدهما: تتبّع أقوال جميع العلماء من زمان الشيخين إلى زماننا هذا، فيحصل من ذلك القطع بالاتّفاق، وهو كاشفٌ عن رضا الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بالحكم، أو وجود نصّ معتبرٍ عند الكلّ.
ثانيهما: تتبّع الإجماعات المنقولة.
ثم ذكر ادّعاء الشيخ الإجماع على حجّية خبر الواحد، وذكر كلامه المحكيّ عنه في العُدّة((1)) بطوله. وذكر أيضاً ادّعاء الإجماع من السيّد رضيّ الدين عليّ بن طاووس، ومن العلاّمة والمجلسي قدّس سرّهم.
وأفاد في جواب الإشكال _ بأنّ ذلك لا يفيد القطع بتحقّق إجماع العلماء _: أنّ هذا الإجماع _ مضافاً إلى كون مدّعيه هؤلاء الأكابر من العلماء _ معتضد بقرائن كثيرة تدلّ على صدق مضمونه، وتوجب القطع بتحقّقه.
منها: ما ادّعاه الكشّي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة.((2)) فإنّه لا معنى للتصحيح المجمع عليه إلّا عملهم به.
ص: 170
ومنها: دعوى النجاشي كون مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب.((1)) وهذا کلامٌ يدلّ على عمل الأصحاب بخبر الواحد إذا كان راويه ثقة. وليست مقبولية مراسيله لأجل القطع بالصدور، بل لأجل أنّه لا يروي إلّا عن الثقة، كما لا يخفى. وقد ادّعى الشهيد في الذكرى أيضا هذا الاتّفاق. وعن كاشف الرموز تلميذ المحقّق: أنّ الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي.
ومنها: ما ذكره ابن إدريس في رسالة «خلاصة الاستدلال» الّتي صنّفها في مسألة فورية القضاء في مقام دعوى الإجماع على المضايقة، وأنّها ممّا أطبقت عليه الإمامية إلّا نفرٌ يسيرٌ من الخراسانيّين. قال في مقام تقريب الإجماع: إنّ ابني بابويه، والأشعريّين كسعد بن عبد الله وسعيد بن سعد ومحمد بن عليّ بن محبوب، والقميّين أجمع كعليّ بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد عاملون بالأخبار المتضمّنة للمضايقة؛ لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته. انتهى.
فهو، _ أي ابن إدريس(قدس سره) _ استدلّ على مذهب الإمامية بذكرهم لأخبار المضايقة وذهابهم إلى العمل برواية الثقة.
ومنها: کلام المحقّق(قدس سره) في المعتبر الّذي يستفاد منه بأنّ العلماء قد يعملون بخبر المجروح كما يعملون بخبر العدل وإن لم يكن مفيداً للعلم.((2))
ومنها: ما ذكره الشهيد _ رفعت درجته _ في الذكرى، والمفيد الثاني ابن شيخنا الطوسي(قدس سره) من عمل الأصحاب بشرائع الشيخ أبي الحسن عليّ بن بابويه(قدس سره) عند إعواز النصوص تنزيلاً لفتاويه منزلة رواياته.
ص: 171
ومنها: شهادة المحدّث المجلسي(قدس سره) في البحار بأنّ عمل أصحاب الأئمّة(علیهم السلام) بالخبر غير العلمي متواترٌ بالمعنى.
ومنها: ما ذكره البهائي(قدس سره) بأنّ الصحيح عند القدماء: ما كان محفوفاً بما يوجب ركون النفس إليه. وذكر فيما يوجب الوثوق اُموراً لا تفيد إلّا الظنّ. ومعلوم أنّ الصحيح هو المعمول به، وليس هذا مثل الصحيح عند المتأخّرين في أنّه قد لا يعمل به لإعراض الأصحاب عنه أو لخللٍ آخر، فالمراد أنّ المقبول عندهم ما تركن إليه النفس وتثق به.((1))
هذا ملخّص ما أفاده الشيخ _ رضوان الله تعالى عليه _ في المقام في عدّة صفحات.((2))
أقول: أمّا الإجماع القولي على حجّية خبر الواحد.
ففيه: أوّلاً: لو فرض تحقّق الإجماع القولي، فهو إنّما يفيد صحّة المجمع عليه إذا لم يكن من المسائل الفرعية. وأمّا إذا كان من المسائل الفرعية الّتي استنبطوا حكمها من الاُصول ومن باب تطبيق الكبرى على الصغرى وردّ الفرع على الأصل، فلا يفيد صحّة المجمع عليه، لعدم كشف ذلك عن وجود دليلٍ معتبرٍ، ولعدم كونه موجباً للحدس وحصول القطع برأي الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ).
كما أنّه لا حجّية للإجماع إذا كان المجمع عليه من المسائل العقلية، ولذا نرى أنّ قدماء العلماء من أهل المعقول وغيرهم من قبل الإسلام إلى عص_رنا هذا أجمعوا على كون الصوت مثلاً غير قارٍّ بالذات، مع أنّه قد ثبت في عص_رنا هذا خلاف ذلك بالحسّ.
وثانياً: لا طريق لتحصيل ذلك الإجماع على الوجه الأوّل الّذي ذكره؛ فإنّا بعد تتبّع
ص: 172
کلمات العلماء لم نظفر على کلمات القائلين بحجّية الخبر إلّا قليل منهم.
وأمّا ثبوته من طريق تتبّع الإجماعات المنقولة.
فهو أيضاً كذلك؛ فإنّ مجرّد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك مع كون حالهم في الظفر بأقوال العلماء حالنا، وعدم عثورهم على أقوال كثير من العلماء، بل ربما يمكن أن يكون الظفر بأقوال العلماء في زماننا أسهل من زمانهم، كما لا يخفى.
هذا مضافاً إلى أنّ الإجماع الّذي ادّعاه الشيخ _ رضوان الله عليه _ كما أفاد الشيخ الأنصاري(قدس سره) لا يفيد إجماع من بعده من العلماء واتّفاقهم على ذلك، وهكذا إجماع غيره ممّن ادعى الإجماع.
ومضافاً إلى أنّ الشيخ لم يدع الإجماع القولي، بل ادعى الإجماع العملي كما ينادي بذلك قوله: «والذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة» إلى قوله: «إلى زمان جعفر بن محمد(عَلَيْهَا السَّلاَمُ) الّذي انتشر منه العلم وكثرت الرواية من جهته».
وهكذا السيد الجليل رضيّ الدين بن طاوس والعلّامة والمجلسی(قدس سره) فإنّهم إنّما ادّعو الإجماع العملي لا القولي.
وأمّا ادّعاء إجماع المسلمين على العمل بالخبر، وادّعاء إجماع الصحابة كما ادّعاه الشافعي فغير مفيدٍ لعدم تحقّق إجماع المسلمين ولا الصحابة على العمل بالخبر بما أنّهم مسلمون، بل بما أنّهم عقلاء. نعم، لو ثبت إجماعهم على العمل بخصوص الأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة يمكن دعوى ذلك.
وأمّا ادّعاء الإجماع على حجّيته حتى من السيّد(قدس سره) وأتباعه، لانسداد باب القطع بالأحكام بالنسبة إلى زماننا دون زمانه بأنّه ذهب إلى عدم حجّية الخبر في مثل زمانه دون زماننا.
ففيه: أنّه لا فرق في انسداد باب القطع والعلم بين زماننا وزمانه بل وزمان المعصومين(علیهم السلام)، لعدم تمكّن المسلمين الساكنين في البلاد النائية والممالك البعيدة غالباً
ص: 173
من درك فيض حضورهم وسعادة زيارتهم، فلم يكن لهم طريقٌ إلّا الروايات الواردة عنهم. مع أنّ الروايات ما كانت مجموعة ومضبوطة مثل زماننا، بل ربما كان عند أحدٍ حديثٌ وعند الآخر حديثان وعند غيره أزيد أو أقلّ، بخلاف زماننا فإنّ الجوامع الأربعة وغيرها من الكتب تكون بيد أكثر أهل العلم، فيمكن أن يدّعى أنّ إنفتاح باب العلم في زماننا هذا تكون دائرته أوسع من زمان السيّد(قدس سره) وأتباعه.
وكيف كان، فالإنصاف عدم تمامية هذه الوجوه لإثبات حجّية الخبر.
ومثلها الآيات والأخبار، فإنّ استفادة حجّيته _ ولو إمضاءً _ من الآيات لا تخلو من إشكالٍ.
وأمّا الأخبار فاستفادة ذلك منها لا تكون إلّا إمضاءً من باب عدم الردع بعد قيام سيرة العقلاء على العمل بالخبر كما تدلّ عليه رواياتٌ كثيرةٌ دالةٌ على عمل الأصحاب بالخبر بمرئى ومسمعٍ من المعصومين(علیهم السلام) مع أنّهم لم يردعوهم عن ذلك.
وكيف كان، فما هو عمدة الدليل في باب حجّية الخبر بل ربما يرجع إليه أكثر الأدلّة _ الّتي أقاموها على حجّية الحجج _ هو بناء العقلاء.
لا يخفى عليك: أنّ ما هو المتداول في ألسنة الأصحاب مثل المفيد والمرتض_ى وابن قبة وعامّة المتکلّمين((1)) إلى زمان الشيخ _ رضوان الله عليه _ وتلامذته عدم جواز
ص: 174
العمل بخبر الواحد، وبذلك يردّون كثيراً _ في مقام الاحتجاج على العامّة حينما تمسّكوا بالأخبار _ بأنّها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً وقد تكرّر ذلك في ألسنتهم.
والشيخ أوّل من ردّ على ذلك وكسر صولة هذه العبارة، وبيّن ما هو الحقّ في المقام ومراد الأصحاب بقوله في العدّة: «وأمّا ما اخترته من المذهب فهو: أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويّاً عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أو عن واحدٍ من الأئمّة(علیهم السلام)، وكان ممّن لا يطعَن في روايته ويكون سديداً في نقله، ولم تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر، لأنّه إن كانت هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجباً _ ونحن نذكر القرائن فيما بعد _ جاز العمل به... إلخ».((1))
وليس معنى ما ذكره تقييد الحجّية بما إذا كان مرويّاً عن النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم وكان الراوي ممّن لا يطعَن في روايته وسديداً في نقله ولم تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمنته الرواية؛ فإنّ لزوم كون الخبر مرويّاً عن النبيّ ممّا اتّفق عليه الكلّ، وكفاية كونه مرويّاً عن أحد الأئمّة أيضاً من جهة أنّهم بمنزلته في ذلك وحجّية قولهم لخبر الثقلين وغيره، وكذا استحكام الراوي وكونه ممّن لا يطعَن في روايته، وكذا عدم وجود القرينة فإنّ مع القرينة ليس الاتّكال على الخبر بل على القرينة.
نعم، ما يكون قيداً لحجّية الخبر على ما اختاره هو كونه مرويّاً من طرق أصحابنا القائلين بالإمامة.
ثم إنّه بعد ما أفاد إجماع الفرقة المحقّة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصنيفاتهم من عهد النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ومن بعده من الأئمّة إلى جعفر بن محمد(عَلَيْهَا السَّلاَمُ) قال : «فإن قيل: كيف تدَّعون الإجماع على الفرقة المحقّة في العمل بخبر الواحد، والمعلوم من حالها أنّها لا ترى
ص: 175
العمل بخبر الواحد، كما أنّ المعلوم من حالها أنّها لا ترى العمل بالقياس، فإن جاز ادّعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر؟ قيل لهم: المعلوم من حالها الّذي لا ينكر ولا يدفع أنّهم لا يرون العمل بخبر الواحد الّذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصّون بطريقه، فأمّا ما يكون راويه منهم وطريقة أصحابهم فقد بيّنا أنّ المعلوم خلاف ذلك، وبيّنا الفرق بين ذلك وبين القياس أيضاً، وأنّه لو كان حظرُ العمل بخبر الواحد معلوماً لجرى مجرى العلم بحظر القياس، وقد علم خلاف ذلك».((1))
ولا يخفى عليك: أنّ الإشكال بحسب الظاهر واردٌ على الشيخ _ رضوان الله عليه _ ولكن المتتبّع البصير يرى أنّه أجاد فيما أفاد، فإنّ الإمامية قد ابتلوا بقومٍ كان تمام أساس مذهبهم من الاُصول والفروع مبنيّاً على خبر الواحد وهم العامّة، فإنّ الروايات المتواترة قليلة جدّاً بل لا يبعد ادّعاء عدم وجودها أصلاً، فالخبر المعروف المرويّ عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «إنّما الأعمال بالنيات» من الأخبار الّتي ذكر كثيرٌ من علمائهم في كتبهم تواتره بل ربما كان في نظرهم بحيث لم يكن في جهة التواتر خبرٌ أقوى منه بل ربما لا يعرفون خبراً متواتراً غيره إلّا أنّنا بعد التتبّع التامّ وجدنا انتهاء سند هذا الخبر إلى شخص واحدٍ وهو عمر بن الخطّاب.
فعلى هذا، يتمسّكون في الاُصول والفروع بكلّ خبر واحد ويقولون بعدالة کلّ واحد من الصحابة، ولذا دخل في مذهبهم سيّما في الاُصول المطالب العجيبة والعقائد السخيفة الّتي قامت الضرورة على بطلانها كالتجسيم وغيره من الخرافات الّتي جلّ شأن الإسلام ونبيّه الكريم من أن يسندها إليه تعالى. تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً.
وبالجملة: فالقوم من أوّل الأمر تمسّكوا بخبر الواحد في أمر الخلافة الّتي هي من أهم الاُمور، وهو ما رواه أبو بكر عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «الأئمّة من قريش».((2))
ص: 176
واستند هو أيضاً في منع فاطمة(عَلَيْهَا السَّلاَمُ) عن فدك بما رواه نفسه وحده عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «نحنُ معاشرَ الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة».((1))
وكثيراً ما يرجعون إلى الناس في حكم ما يتّفق من الحوادث والوقائع، فإذا أخبر أحدٌ: أنّ النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فعل كذا، أو قال كذا، يأخذون به، كما نرى هذا كثيراً بالنسبة إلى أبي بكر وعمر. ومن الواضح: أنّه لابدّ لهم من ذلك، لعدم وجود مستندٍ على مذهبهم لفقههم كما يكون للإمامية وهو الإمام المعصوم الّذي لا تخلو الأرض منه في عصر من أعصار التكليف. والإمامية في مباحثاتهم ومجادلاتهم مع العامّة لم يروا بدّاً إلّا نفي حجّية خبر الواحد بالمرّة، فإنّ مع الاعتراف بحجّية الخبر في مقام الاحتجاج لابدّ لهم من التسليم، لعدم إمكان الخدشة في سند الروايات الواردة من طرقهم حتى ما رواه أمثال أبي هريرة والوليد بن عقبة _ الّذي نزلت الآية في فسقه _ ومعاوية والمغيرة بن شعبة وعمران بن حطّان الخارجي،((2)) فإنّ تفسيق هؤلاء في مثل تلك الأزمنة يؤدّي إلى فتنٍ عظيمةٍ ومفاسد كبيرةٍ، فلذا أنكروا في مقابلهم حجّية الخبر رأساً، مع عملهم فيما بينهم بما كان وارداً من طرقهم عن النبيّ والأئمّة(علیهم السلام).
ولأجل ما في هذه الأخبار المروية عن طرق العامّة ممّا لا يقبله عقلٌ سليمٌ ولا يوافقه كتاب الله الكريم ظهر مذهب الاعتزال، وقامت المعتزلة على خلاف الأشاعرة، ووقعت بينهم الوقائع والفتن العظيمة، ورمت الأشاعرة المعتزلة بالتكفير والزندقة والإلحاد
ص: 177
والرجوع عن سنّة النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وغير ذلك من الافتراءات، ونسبت المعتزلة الأشاعرة إلى الجمود والإعراض عن حكومة العقل بالمرّة، والعقائد الباطلة الّتي لا يشكّ في بطلانها من له أدنى التفات بما يحكم به العقل مستقلاً. وتفصيل ذلك خارجٌ عن وضع الكلام.
ص: 178
إعلم: أنّ من المسائل المتفرّعة على مسألة حجّية الخبر مسألة الإجماع.
وهو لغةً يستعمل في معنيين:((1))
أحدها: العزم، ومنه ما روي عن النبي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «لا صيام لمن لم يُجمِع الصيام من الليل».((2))
ثانيها: الاتّفاق، ومنه قولهم: «أجمع العلماء على كذا» إذا اتّفقوا عليه.
وما يضاف إليه على هذا المعنى إن كان أهل حرفةٍ وطبقةٍ خاصّةٍ، فلا يرتبط بما نحن فيه، لعدم كون هذا الإجماع ممّا يحتجّ به. وأمّا إن اُطلق واُضيف إلى اُمّة نبيّنا(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)،
ص: 179
فهو الّذي وقع الخلاف في حجّيته، وذهبت العامّة إلى حجّيته، وحكي عن النظّام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشّر القول بعدم حجّيته.((1))
واختلف من قال بحجّيته في تفسيره، فذهب داود الظاهري وكثيرٌ من أصحاب الظاهر إلى أنّه عبارةٌ عن اتّفاق الصحابة دون غيرهم من أهل الأعصار.((2)) وذهب أنس بن مالك ومن تابعه إلى أنّه عبارةٌ عن اتّفاق أهل المدينة، وهو حجّة في کلّ عص_رٍ من الأعصار. وفس_ّره الأكثر بأنّه عبارةٌ عن إجماع أهل الحلّ والعقد من المسلمين على مطلب في عصرٍ واحدٍ.
استدلّوا لحجّية الإجماع تارة:
بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْ_هُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْ_مُ_ؤْمِنينَ نُوَلِّه ِمَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصيراً﴾.((3))
فإنّه تعالى جمع في الوعيد بين مشاققة الرسول واتّباع غير سبيل المؤمنين، ولا شكّ في حرمة مشاققته استقلالاً، فلابدّ من أن يكون اتّباع غير سبيل المؤمنين مثله، وإلّا لم يحسن الجمع بينهما.
كما أنّه لا ريب في كون سبيل المؤمنين عبارةً عن أقوالهم وفتاويهم وسلوكهم في الاُمور الدينية.
ص: 180
واُجيب عنها بوجوه:
منها: منع كون اللام في المؤمنين للاستغراق.
ومنها: أنّه لا يستفاد من الآية إلّا حرمة اتّباع غير سبيلهم ومخالفتهم، لا وجوب موافقتهم.
ويمكن أن يقال: إنّ سبيل المؤمنين عبارةٌ عمّا عليه المؤمنون بما أنّهم مؤمنون وما هو مقتضى إيمانهم لا مطلق ما عليه المؤمنون.
واُخرى بقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ﴾.((1))
وقوله: ﴿وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّةً وَسَطاً﴾.((2))
وجه الاستدلال بهما: اقتضاء كونهم اُمّةً وسطاً وخير اُمّةٍ اُخرجت للناس عدم اجتماعهم على الباطل لوجود المنافاة بينهما.
وفي الاستدلال بهما أيضاً مضافاً إلى أنّ في بعض القراءات: «كُنْتُمْ خَيْرَ أَئِمَّةٍ»،((3)) و ورود بعض الروايات على أنّ المراد بها أئمّة أهل البيت(علیهم السلام)، وكونهم واسطة بين الخلق والخالق، وأنّ المخاطب بخطاب ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ في الآية الثانية الأئمّة الطيّبين(علیهم السلام): أنّ ظاهر الآية الاُولى كونها مسوقة لأجل الترغيب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. والثانية مسوقة لأجل الدعوة إلى الطريق السوي الوسط العدل، والترغيب إلى اتّباعه، وهو الطريق الّذي دعانا إليه نبيّنا(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، فلا ربط لهما بالإجماع، ولا مجال للاستدلال بهما.
ص: 181
وهكذا حال سائر الآيات الّتي استدلوا بها، كقوله تعالى: ﴿وَمِ_مَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةً يَهْدُونَ بِالْ_حَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾.((1))
فإنّ الاُمّة تقع على الواحد وعلى الجماعة. وتقع على جميع الاُمّة على وجه الاستغراق، والشاهد على ذلك قوله في حقّ إبراهيم: ﴿إِنَّ إِبرَاهيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتَاً﴾،((2)) وقوله عزّ من قائل: ﴿وَلَ_م_َّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النّاسِ﴾.((3))
فيمكن أن يكون المراد واحداً من الاُمّة، فلا دلالة لها على حجّية الإجماع بما هو إجماع بل تدلّ على حجّية هذا الواحد ويمكن أن يكون المراد بالاُمّة الأنبياء.
واستدلّوا بالسنّة، وهي ما رووه عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أنّه قال: «لا تجتمع اُمّتي على الخطأ» أو «لا تجتمع اُمّتي على الضلالة» أو «ما كان الله ليجمع اُمّتي على الخطأ» أو «لم يكن الله ليجمع اُمّتي على الخطأ». وقوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «يد الله على (أو مع) الجماعة» و«كونوا مع الجماعة».((4))
وجه الاستدلال بها: أنّ المراد باجتماع الاُمّة ليس اجتماع الجميع من الأوّل إلى يوم القيامة؛ فإنّ معه تنتفي فائدة هذا الكلام ويصير لغواً. وليس أيضاً اجتماع الموجودين وغيرهم ممّن انقض_ى زمانهم؛ لعدم صدق الاجتماع على توافق المعدومين مع الموجودين. فالمراد به هو اجتماع أهل عصرٍ واحدٍ والموجودين من الاُمّة على مسألةٍ واحدةٍ.
ص: 182
واُجيب عن الاستدلال بهذه الرواية:
أوّلاً بضعف سندها، حتى أنّ الشافعي لم يذكرها في أدلّة حجّية الإجماع.
وما يتراءى من بعض الروايات المذكورة في كتب أصحابنا كالاحتجاج من إسناد هذا الحديث إلى النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فيمكن أن يكون ذلك في مقام الاحتجاج على العامّة، وتعليم الشيعة الاستدلال على بطلان مذهب مخالفيهم بما هو مقبولٌ عندهم.
هذا مضافاً إلى ما في هذه الروايات من اضطراب المتن وضعف السند أيضاً، فراجع.
وثانياً: بعدم تمامية دلالته لاحتمال أن يكون عدم اجتماعهم على الخطأ من جهة وجود المعصوم فيهم، لا أن يكون الإجماع بما هو هو حجّة كما هو مذهب العامّة.
إن قلت: هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية، فإنّ ظاهرها أنّ اجتماع الاُمّة بما هم اُمّة حجّة لا بما أنّ الإمام فيهم وواحدهم.
قلت: كما يمكن أن يكون المراد به اجتماع الاُمّة بما هم اُمّة، يمكن أن يكون المراد به اجتماعهم بما أنّ الإمام المعصوم فيهم، وليس لأحدِ الاستظهارين تقدّمٌ على الآخر، مع أنّ الدليل موافقٌ لنا. هذا بعض من الكلام في وجه حجّية الإجماع عند العامّة، والجواب عنه.
وأمّا الإمامية،((1)) فليس هذا الإجماع عندهم حجّة رأساً وبنفسه لو تحقّق، بل بملاك دخول الإمام في المجمعين، وكونه واحداً من الفقهاء وأهل الحلّ والعقد، لعدم خلوّ
ص: 183
زمان التكليف من إمامٍ معصومٍ على ما تقتضيه اُصول مذهبهم، بل هم أركان الأرض((1)) وأمانٌ لأهلها((2)) وأعدال الكتاب((3)) وسفن النجاة.((4))
لا يقال: إذا كان ملاك حجّية الإجماع عندكم رأي الإمام المعصوم من غير أن يكون لغيره دخل في الحجّية فما وجه عنوان الإجماع في كتبكم وذكره في کلماتكم وعدّه من جملة الأدلّة؟
فإنّه يقال: إنّ القوم، أي العامّة سبقونا في طرح مسألة الإجماع في كتبهم، فذكرناها ورددنا عليهم وأوضحنا ما هو الحقّ فيها، ولو لم يسبقنا هؤلاء في ذلك لم تذكر هذه المسألة في كتبنا.
هذا مضافاً إلى أنّ بعضهم كصاحب الغنية والسيّد(قدس سره)((5)) إنّما أرادوا بالإجماع المتكرّر ذكره قول المعصوم(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، والتعبير بالإجماع عن قول المعصوم لمكان كون تصنيفاتهم غالباً في مقابل العامّة وفي أوساطهم الفقهية، فيمكن أنّهم أرادوا بذلك الجري على مجراهم في كتبهم حتى لا يدخل النزاع الواقع بينهم في الإمامة _ الّتي من لوازمها حجّية قول المعصوم في جميع الأعصار _ في کلّ واحدة من المسائل الفقهية، فذكروا في
ص: 184
أوّل كتبهم مرادهم من الإجماع وما يقتضيه اُصول مذهبهم، وعبّروا عن قول الإمام بالإجماع، وأشاروا إلى أنّ مرادهم ليس ما أراده العامّة.
هذا کلّه فيما يتعلّق بالإجماع بالمعنى الّذي فسّر به في کلّمات العامة وهو: إجماع أهل الحلّ والعقد من اُمّة محمد(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) في عصرٍ واحدٍ على أمرٍ.
وأمّا إجماع غيرهم كاتّفاق طائفةٍ خاصّةٍ، فإن كانوا غير الفقهاء والعلماء كأهل الحِرف والصنائع فلا کلام في عدم حجّية إجماعهم.
وأمّا إن كان ذلك اتّفاق علمائنا، أي علماء الإمامية على مطلب، فقد قيل بحجّيته لوجهين:
أحدهما: قاعدة اللطف، كما أفاد الشيخ(قدس سره) وهي: أنّ علماء الإمامية إذا اتّفقوا على مطلبٍ وكان خلاف الواقع يجب على الإمام _ بمقتضى هذه القاعدة _ الإظهار أو إلقاء الخلاف، فحيث وقع الاتّفاق نقطع بموافقة قول الإمام لأقوال المجمعين لا محالة.
ونقل مخالفة السيّد(قدس سره) لهذا البيان، ومَنْعه لزوم موافقة الإمام لما استقرّ عليه رأي علمائنا واتّفقوا عليه، أو إلقاء الخلاف إذا كان رأيه مخالفاً لرأي هؤلاء المجمعين.
وأجاب عن بيان السيّد(قدس سره) بأنّ ذلك لو تمّ لبطلت جميع استدلالات أصحابنا بالإجماع، وأنت خبير بأنّ بطلان استدلال من استدلّ بالإجماع لا يوجب القول بحجّيته.((1))
فهذا الكلام بظاهره غير مستقيم، وقد استشكل عليه بعده أكثر الفقهاء.
ثانيهما: دعوى الحدس، بتقريب: أنّ اتّفاق جميع فقهائنا مع اهتمامهم ودقّتهم في الفتاوى وعدالتهم كاشفٌ عن موافقة فتواهم لرأي الإمام وملازمٌ لقول المعصوم إمّا لكون نفس ذلك الاتّفاق كاشفاً عن إصابتهم للواقع وموافقة رأيهم لرأي الإمام، أو
ص: 185
لملازمة ذلك لوجود دليلٍ معتبرٍ، أو روايةٍ معتبرةٍ عند الكلّ وكشف ذلك الاتّفاق عنه.
وفيه: أنّ المسألة المجمع عليها إن كانت من المسائل العقلية أو المسائل الّتي للعقل دخل في استنباطها فليس لازمه القطع برأي الإمام أو وجود روايةٍ معتبرةٍ؛ لأنّا نرى أنّ أهل المعقول كثيراً ما أجمعوا على أمرٍ عقليٍّ مع ظهور خلافه وبطلانه بعد زمان طويلٍ، وهذا كاتّفاقهم في كثيرٍ من المسائل المذكورة في الطبيعيات مع ظهور بطلان ما اتّفقوا عليه في زماننا.
وإن لم يكن كذلك كالاُصول المتلقّاة، فدعوى ملازمة إجماعهم للقطع برأي الإمام أو وجود دليل معتبرٍ قريبةٌ جدّاً. وأمثلة ذلك كثيرة في الفقه، مثل مسألة العول والتعصيب الّتي ذهبت الإمامية فيها إلى خلاف العامّة، ولذا قلنا مكرّراً: إنّ في المسائل التفريعية لا اعتناء بدعوى إجماع الفقهاء، بل لا اعتداد بإجماعهم لدخالة العقل في استنباط أحكامها، بخلاف الاُصول المتلقّاة والمسائل المعنونة في كتب القدماء لعدم دخل شيءٍ في استنباطها إلّا السمع والنقل، وليس للعقل فيها سبيلٌ. فما ليس طريقه منحصراً في السمع والنقل بل يكون العقل دخيلاً أيضاً في استنباطه ليس إجماعهم فيه كاشفاً عن رأي الإمام ومستلزماً لوجود دليلٍ معتبرٍ أو روايةٍ معتبرةٍ. بخلاف المسائل النقلية المحضة، فإنّه لا مانع من الملازمة المذكورة فيها، ومن يدّعيها فليس بمجازفٍ. هذا تمام الكلام في أصل الإجماع.
وأمّا الكلام في الإجماع المنقول، فقد ذكر الشيخ(قدس سره) لمنع حجّيته مقدّمتين:
إحداهما: أنّ أدلّة حجّية خبر العادل لا تدلّ على أزيد من إلغاء احتمال تعمّد الكذب في خبر العادل، وجعله بالنسبة إليه كالعدم بخلاف الفاسق. وأمّا احتمال
ص: 186
الخطأ والاشتباه فلا فرق في تطرّقه بين خبر العادل والفاسق، ولا دلالة للأدلّة المذكورة على نفيه.
نعم، لا اعتناء بهذا الاحتمال من جهة الأصل _ وهو بناء العقلاء على عدم الاعتناء بذلك الاحتمال _ إذا كان المخبَر به أمراً حسيّاً، أو كان من الاُمور الحدسية الّتي تكون مباديها اُموراً حسّية كالإخبار عن شجاعة زيد وسخاوة عمرو، فإنّ شجاعة زيد مثلاً تعرف بسبب بعض الاُمور الحسية مثل مواقفه ومقاماته في الحروب ومبارزته الأبطال والشجعان، ففي مثل هذا لا يعتني العقلاء باحتمال الخطأ. وأمّا إذا كان المخبر به أمراً حدسيّاً من دون أن تكون مباديه من الاُمور الحسيّة بل كان استنباطاً واجتهاداً، فليس لرفع اليد وعدم الاعتناء بهذا الاحتمال أصلٌ وبناءٌ من العقلاء.
ثانيتهما: أنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة بل العامّة _ الّذين هم الأصل له ويدّعون أنّه الأصل لهم((1)) _ هو: اتّفاق جميع أهل العصر، أو اتّفاق أهل الحلّ والعقد، أو اتّفاق جميع العلماء في عصرٍ واحدٍ على أمرٍ((2)). إلّا أنّه حجّة عند العامّة بنفسه بحيث يكون قول کلّ واحدٍ من المجمعين جزءاً من الحجّة((3)). وعند الإمامية حجّة لكونه مشتملاً على قول المعصوم، وفي الحقيقة الحجّة عندهم قول الإمام لا أقوال غيره من المجمعين.
والمدّعي للإجماع إن كان ينقل قول الإمام وقول غيره من العلماء، بحيث يكون
ص: 187
طريقه لاستكشاف قول الإمام أقوال غيره من العلماء، يكون مستنده لاعتبار هذا الإجماع _ من حيث نقل المنكشف والمسبّب وهو قول الإمام وعلم حاكيه بقوله _ إمّا قاعدة اللطف، أو التقرير وإن كان ذلك أيضاً راجعاً إلى قاعدة اللطف، أو الملازمة العادية بين قول المجمعين وبين قول الإمام لقضاء العادة باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الجهد والوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام، واستحالة توافق المرؤوسين عادةً على رأي يكون مخالفاً لرأي رئيسهم، أو الملازمة الاتّفاقية.
وإن كان ناقلاً لقول الإمام وقول غيره لكن لا على النحو المذكور من الطولية وكون العلم بقول الإمام مترتّباً على العلم بأقوال غيره من العلماء، بل على نحو من العرضية بأن يحصل قول الإمام من طريق الحسّ باستماع قوله في ضمن استماعه أقوال جماعة لا يعرفهم بأعيانهم، فيحصل له القطع بقول المعصوم. فدلالة الإجماع على قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) تكون بالتضمّن. وهذا القسم من الإجماع في غاية القلّة لو لم نقل بعدم وقوعه واتّفاقه جزماً.
وأنت خبيرٌ بعدم كفاية واحدٍ من هذه الوجوه لإثبات حجّية نقل الإجماع من حيث المنكشف والمسبّب.
أمّا إذا كان اعتباره عند ناقله من جهة الحسّ واشتماله على قول الإمام للعلم بدخوله في المجمعين لاستماع الحكم من جماعةٍ كان الإمام فيهم وإن كان لا يعرفه بعينه، فهو ممّا لا يتّفق إلّا نادراً، بل يمكن دعوى عدم اتّفاقه جزماً.
وأمّا اشتماله على قول الإمام من جهة قاعدة اللطف أو التقرير، فهي مردودة عند المحقّقين من المتأخّرين.
وأمّا اشتماله على قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بدعوى وجود الملازمة بين تطابق رأي الفقهاء ورأي الإمام، فهو يبتني على الحدس الّذي قد يتّفق لنا وقد لا يتّفق. هذا ملخّص ما أفاده
ص: 188
الشيخ(قدس سره) في نفي حجّية الإجماع المنقول من حيث المنكشف((1)). وأمّا من حيث الكاشف فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله.
ولا يخفى عليك: أنّ المتراءى من کلامه(قدس سره) أنّه توهّم حص_ر بحثهم عن حجّية الإجماع المنقول بالإجماعات المنقولة المتحقّقة في زمان الغيبة، وأنّ الإمام الّذي يكون قوله مستنداً لحجّية الإجماع هو إمام العصر _ أرواحنا فداه _ دون غيره، ولذا في بيان إمكان كون مستند علم الحاكي بقول الإمام هو الحسّ مثَّل بما إذا سمع الحكم من الإمام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم، فيحصل له العلم بقول الإمام. مع أنّه لا فرق فيما هو مستند الإجماع بين زمان الغيبة وغيره من الأعصار السابقة وأزمنة الحضور. وليس في کلمات القدماء حصر العلم بدخول الإمام باستماع ناقل الإجماع قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في ضمن جماعة لا يعرفهم بأعيانهم، بل كما يمكن أن يكون هذا وجه علم الحاكي بقول الإمام يمكن أن يكون وجه علمه دلالة الروايات المأثورة عنهم. وإنّما ادّعوا الإجماع لأجل كون كتبهم في معرض ملاحظة علماء العامّة وفقهائهم فرأوا أنّ التمسّك بالروايات والأخبار المرويّة عن أهل البيت(علیهم السلام) في كلّ مسألة يوجب تجديد النزاع الواقع بينهم في الخلافة والإمامة في کلّ بابٍ من الفقه، فادّعوا الإجماع تخلّصاً من تجديد هذا النزاع في الفقه واكتفاءً بما ذكروه في غير الكتب الفقهية من الكتب الكلامية والاُصولية، لوجود ما هو الملاك في حجّية الإجماع عندنا وهو قول الإمام. ومع ذلك يشيرون إلى ذلك، أي أنّ المراد من هذا الإجماع ليس اتّفاق جميع الاُمّة أو جميع الفقهاء، كما أشار إليه ابن زهرة في الغنية في مقام الاستدلال للمسألة بقوله: «الإجماع المتكرّر ذكره» وغيره بقوله: «الإجماع المشار إليه».
ص: 189
وغرضهم هو الإجماع المشار إليه في صدر الكتاب وهو قول الإمام. ولذا ترى أنّهم في مثل مسألة العول والتعصيب((1)) وحرمان الزوجة مع وجود الروايات المتواترة يتمسّكون بالإجماع، مع أنّ من الواضح عدم كون مراد ناقله أنّه تشرّف بحضور الإمام في ضمن ملاقاته جماعة لم يعرفهم بأعيانهم، بل المراد حصول العلم برأي الإمام لهذه الروايات المتواترة القطعية، هذا.
ويشهد على ما ذكرناه ما يجده المتدبّر في کلمات الشيخ(قدس سره)، فإنّه بعد ما ذكر في العدّة عدم كون ملاك حجّية الإجماع عندنا ما هو ملاكٌ لحجّيته عند العامّة، وتعرّض لما تمسّك به العامّة لإثبات مذهبهم وأبطل ما ذهبوا إليه وأجاب عن استدلالاتهم، قال: «فصلٌ: في كيفية العلم بالإجماع ومَن يُعتَبر قوله فيه».
إذا كان المعتبر في باب كونهم حجّة قول الإمام المعصوم(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، فالطريق إلى معرفة قوله شيئان:
أحدهما: السماع منه، والمشاهدة لقوله.
والثاني: النقلُ عنه بما يوجب العلم، فيعلم بذلك أيضاً قوله.
هذا إذا تعيّن لنا قول الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، فإذا لم يتعيّن لنا قول الإمام ولا يُنقل عنه نقلاً يوجب العلم، ويكون قوله في جملة أقوال الاُمّة غير متميّزٍ منها، فإنّه يحتاج أن ينظر... إلخ».((2))
وليس في کلامه ما يستفاد منه انحصار طريق العلم بقول الإمام لناقل الإجماع بالاُمور الّتي ذكرها الشيخ الأنصاري(قدس سره)، كما ينادي بأعلى صوته استدلاله في الخلاف
ص: 190
بالإجماع، فإنّ مراده ليس إلّا قول الإمام المستكشف عن النصّ القطعي الّذي يستكشف منه قول غيره من فقهائنا.
ولا وجه لأن يقال بأنّ مراده _ في کلّ مسألةٍ من هذه المسائل _ من دعوى الإجماع نقل قول الإمام وغيره على أحد النحوين المذكورين.
ألا ترى أنّه قال في الخلاف (في مسألة العدول من الفرادى إلى الجماعة، وفي مسألة صلاة ذات الرقاع) بالجواز للأصل، (وفي صلاة الجماعة أيضاً) قال بجوازه للأصل، وقال في محلٍّ آخر من صلاة الجماعة:
(مسألة، فيها ثلاث مسائل:
أوّلها: من صلّى بقومٍ بعض الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف إماماً فأتمّ الصلاة جاز ذلك، وبه قال الشافعي في الجديد.((1))
وكذلك إن صلّى بقومٍ وهو محدثٌ أو جنبٌ ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه، خرج واغتسل واستأنف الصلاة. وقال الشافعي إذا عاد أتمّ الصلاة، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ثم صارت جماعة بإمام.
الثانية: نقل نيّة الجماعة إلى الانفراد قبل أن يتمّ المأموم يجوز ذلك، وتنتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الانفراد، وبه قال الشافعي.((2)) وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته.((3))
الثالثة: أن ينقل صلاة الانفراد إلى صلاة جماعةٍ، فعندنا أنّه يجوز ذلك، وللشافعي
ص: 191
فيه قولان أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.((1)) والثاني: يجوز، وهو الأصحّ عندهم، وهو اختيار المزني مثل ما قلناه).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير، ولأنّه لا مانع يمنع منه، فمن ادّعى المنع فعليه الدلالة.((2)) انتهى.((3))
وقد تتبّعنا بالتتّبع التامّ كتابيه الكبيرين التهذيب والاستبصار فلم نجد فيهما روايةً يمكن أن تكون مدركاً لهذه المسائل إلّا روايات الاستخلاف وهي لا تدل إلّا على المسألة الاُولى، ولا دلالة لها على ما ذكره في الفرع الثاني والثالث؛((4)) إلّا أنّه استفاد حكم المسألة الثالثة وهو العدول من الانفراد إلى الجماعة من هذه الأخبار من جهة أنّ
ص: 192
صلاة المؤتمين بعد صيرورتها فرادى بسبب عروض عارضٍ للإمام تصير جماعةً لصحة ائتمامهم فيما بقي من الصلاة بمن استخلفه الإمام السابق أو استخلفوه بمقتض_ى هذه الروايات. واستفاد حكم الفرع الثاني وهو جواز العدول من الجماعة إلى الفرادى من صيرورة صلاة المؤتمّين بالإمام الّذي حدث له حادث فرادى بعد حدوث الحادث.
والحاصل: أنّ الشيخرحمه الله في هذه المسائل تمسّك بالإجماع مع وضوح عدم وجود مستندٍ له لقول الإمام إلّا الأخبار، وما جعله مدركاً لحكم هذه المسائل، ومبنی دعوى الإجماع ليس إلّا أخبار الاستخلاف.
فظهر من جميع ما ذكر أنّ اشتمال الإجماع على قول الإمام وكونه معتبراً من حيث المنكشف ليس منحصراً في استماع قول الإمام في ضمن استماع أقوال جماعة لا يعرفهم بأعيانهم، ولا غير هذا الوجه ممّا قيل بكونه كاشفاً عن رأي الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في زمن الغيبة.
ص: 193
ص: 194
ممّا قيل بحجّيته ومنجّزيته بالخصوص: الشهرة الفتوائية.
واستدلّ على حجّيتها بمرفوعة زرارة،((1)) ومقبولة عمر بن حنظلة.((2))
والاستدلال بالمرفوعة مبنيٌّ على كون المراد من قوله: «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر» مطلق المشهور فتوىً كان أو روايةً. أو على كون إناطة الحكم بالاشتهار دليلاً على حجّيته في نفسه.
وأمّا المقبولة، فوجه الاستدلال بها: أنّ المراد بالمجمع عليه المأمور بأخذه بقرينة قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور» ليس ما يكون كذلك حقيقةً، بل ما يكون كذلك عرفاً ومسامحةً، فيكون التعليل المذكور في الرواية وهو قوله( علیه السلام): «فإنّ المجمع
ص: 195
عليه لا ريب فيه» دالّا على كون المشهور مطلقاً ممّا يجب العمل به. ومع ما ذكر لا اعتناء بكون مورد التعليل الشهرة في الرواية.
وقد أجاب الشيخرحمه الله عن الاستدلال بالرواية الاُولى: بأنّه يرد عليه، مضافاً إلى ضعفها حتى أنّه ردّها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدّث البحراني: أنّ المراد بالموصول ليس إلّا خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق المشهور، ألا ترى أنّك لو سئلت عن أنّ أيّ المسجدين أحبّ إليك؟ فقلت: ما كان الاجتماع فيه أكثر، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبية کلّ مكانٍ يكون فيه الاجتماع أكثر بيتاً كان أو سوقاً أو خاناً.
هذا مع أنّ الشهرة الفتوائية لا تتحقّق في طرفي المسألة، فقوله: «يا سيّدي إنّهما مشهوران مأثوران» أوضح شاهد على أنّ المراد الشهرة في الرواية الحاصلة، بأن تكون الرواية ممّا اتّفق الكلّ على روايته أو تدوينه، وهذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.
ومن هنا يعلم الجواب عن الاستدلال بالمقبولة، وأنّه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتى تص_رف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر، فإنّ إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إطلاقٌ حادثٌ مختصٌّ بالاُصوليّين، وإلّا فالمشهور هو الواضح المعروف ومنه «شَهَر فلان سيفه» فالمراد أنّه يؤخذ بالرواية الّتي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحدٌ منهم، ويترك ما لا يعرفه إلّا الشاذّ ولا يعرفه الباقي.((1)) هذا ملخّص ما أفاده الشيخ(قدس سره).
وتوضيح الكلام وبيان ما هو الحقّ في المقام يقع في مقامين:
ص: 196
المقام الأوّل: في ما هو أوّل المرجّحات، فهل هو الشهرة الفتوائية أو الشهرة بحسب الرواية؟
والمقام الثاني: في حجّية الشهرة الفتوائية _ ولو لم تكن على طبقها روايةٌ _ وعدمها.
أمّا المقام الأوّل: فيمكن أن يدّعى أنّ الإرجاع إلى ما هو المجمع عليه وأخذه في مقابل الشاذّ إن كان بملاحظة كون الرواية ممّا اتّفقوا على روايتها أو تدوينها _ كما ذكره الشيخ(قدس سره) أثناء کلامه _ وإن كان ربما يستظهر خلافه ممّا ذكره ثانياً في ذيل کلّامه بقوله: «فالمراد أنّه يؤخذ بالرواية الّتي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحدٌ منهم»؛ فإنّ معرفة الرواية وعدم إنكارها ظاهرٌ في كون مضمونها كذلك، إلّا أنّ الحقّ موافقة ما أراده من هذه العبارة مع عبارته الاُولى.
فيمكن دعوى عدم استقامة ما يستفاد من الرواية بحسب هذا البيان، فإنّ المراد من المجمع عليه إن كان اتّفاق الكلّ على روايته وتدوينه فيجب ترجيح الرواية به ولو كان الخبر المشهور بحسب الرواية شاذّاً بحسب الفتوى بأن كان رأي أكثر الأصحاب على خلافه وبطلان مضمونه، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون مرجّحاً. والشاهد على ذلك التعليل المذكور في الرواية وهو قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» فإنّ ما يصحّ أن يتّصف بكونه ممّا ليس فيه ريبٌ هو مضمون إحدى الروايتين لا لفظها.
إن قلت: إنّ هذا مخالف لظاهر الرواية، فإنّ الظاهر من لفظ المجمع عليه ما اتّفق عليه الكلّ من إحدى الروايتين، وهو يتّفق في الرواية لإمكان اتّفاقهم في روايتها أو تدوينها مع رواية بعضهم ما يعارضها أيضا، ولا يتّفق ذلك في الفتوى لعدم إمكان اتّفاق الكلّ على رأي مع كون رأي بعضهم غيره.
قلت: المراد بكون المجمع عليه ليس اتّفاق الكلّ لعدم وجود رواية بهذه الصفة، ولو وجدت فليس ممّا يعتنى بشأنه لقلّته، وليست في الأخبار المتعارضة رواية اتّفق
ص: 197
جميع القدماء على تدوينها أو روايتها. فالمراد من المجمع عليه والمشهور أن تكون الرواية بحسب المضمون أو بحسب اللفظ بحيث يعرفها هذا الراوي وذاك الراوي وغيرهما من الرواة، بخلاف الشاذّ فإنّه ممّا لا يعرفه هذا الراوي وذاك وغيرهما من الرواة ولكن يعرفه الشاذّ من الرواة دون غيره.
فإن قلت: يمكن أن يكون مورد الرواية ممّا توافق فيه الشهرة الفتوائية والروائية، فلا مجال لحملها على الاُولى والقول بكونها بنفسها أوّل المرجّحات.
قلت: ما هو الملاك في الحكم بالترجيح ليس إلّا الشهرة في الفتوى دون غيرها، لكونه بالنسبة إليها كالحجر بجنب الإنسان، فالشهرة الفتوائية مرجّحةٌ سواءٌ كانت الرواية مشهورةً أم لا.
إن قلت: إنّ هذا الاستظهار خلاف ما ذكر في الرواية وهو كون الخبرين مشهورين لعدم إمكان كونهما مشهورين بحسب المضمون، وهذا بخلاف الشهرة في الرواية لإمكان كونهما مشهورين وممّا اتّفق الكلّ على روايته وتدوينه.
قلت: إنّ الخبرين مشهوران بحسب المضمون إذا كان مضمون کلّ واحدٍ منهما ممّا أفتى به كثيرٌ من الأصحاب وكان معروفاً عندهم بحيث لا يكون من الأقوال والآراء الشاذّة.
هذا ملخّص الكلام في المقام الأوّل وهو: كون الشهرة في المضمون أوّل المرجّحات وهو مطابق لعمل الفقهاء؛ فإنّهم يأخذون في مقام التعارض بالخبر الّذي يكون مشهوراً بحسب المضمون.
وأمّا المقام الثاني: وهو حجّية الشهرة الفتوائية ولو لم تكن على طبقها رواية.
فيمكن أن يقال بعد ما ذكرنا أنّه لا دخل لوجود الخبر في مرجّحية الشهرة بل هي بنفسها كذلك، كما هو مقتضى التعليل المذكور في قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»، فإنّ الشهرة ممّا لا ريب فيه، ولا دخالة لوجود الخبر وعدمه في كونها هكذا.
ص: 198
إن قلت: فعلى هذا، يلزم أن تكون مخالفة العامّة أيضاً كذلك؛ فإنّ وجوب الأخذ بما خالفهم أيضاً معلّل بأنّ فيه الرشاد وأنّ الرشد في خلافهم، كما في غير هذه الرواية، ولا دخل لكون الرشد في خلافهم بين وجود الخبر وعدمه، فلو دار الأمر بين الأخذ بفتوى الموافق لهم وفتوى المخالف لهم يجب الأخذ بفتوى المخالف.
قلت: ما ذكرت إنّما يتوجّه إذا كانت فتوى المخالف للعامّة متعيّنة، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة وكان أحدهما مخالفاً لهم والآخر موافقاً. أمّا مع عدم كونها متعيّنة لاحتمال كون الفعل الّذي هو بحسب الفتوى الموافقة لهم حرامٌ واجباً كان أو مباحاً أو مكروهاً أو مستحبّاً، فلا يمكن الإحالة إليه، وهذا بخلاف فتوى المشهور فإنّها تكون بنفسها متعيّنة، هذا.
ولكنّ الظاهر عدم صحّة إلغاء الخصوصية بالمرّة. نعم، لا مانع من إلغاء خصوصية كون الخبر الّذي يكون مشهوراً بحسب المضمون «أحد الخبرين المتعارضين» فلو لم يكن منهما يجب العمل به أيضاً ويكون حجة إذا كان مشهوراً بحسب المضمون. ولكن يشكل القول بكون الاشتهار بحسب المضمون بنفسه حجّة ولو لم يكن على وفاقه خبرٌ، لاحتمال دخالة وجود الخبر في حجّيته.
وبهذا يمكن الاستدلال على ما يتكرّر كثيراً في کلام متأخّري المتأخّرين من جبر ضعف السند بفتوى المشهور ولو لم يستندوا في فتواهم إلى هذا الخبر الضعيف. فالاشتهار بحسب المضمون يكون جابراً لضعف سند الخبر وسبباً لحجّيته ووجوب الأخذ به.
هذا، ويمكن أن يقال في مقام حجّية الشهرة: إنّ الفتاوى المذكورة في الكتب الفقهية على ثلاثة أقسام:
إحداها: الفتاوى المتلقّاة بنفسها من المعصوم الّتي لا يعمل في معرفتها استنباط ولا يتوسّط النظر في فهم ما اُريد منها.
ص: 199
ثانيتها: الفتاوى المتلقّاة من المعصوم الّتي لابدّ من إعمال النظر والاستنباط في معرفتها، لوجود الإجمال والإبهام فيها.
ثالثتها: الفتاوى التفريعية، والفروع الّتي تستنبط من الاُصول الأوّلية الفقهية.
ولا ريب في عدم حجّية الشهرة في المسائل التفريعية الّتي لم يرد فيها نصٌّ بالخصوص، وإنّما استنبطوا حكمها من الروايات والأخبار الواردة عنهم(علیهم السلام) بسبب إعمال النظر والاستنباط.
وكذا لا حجّية في الفتاوى المتلقّاة الّتي تكون من القسم الثاني؛ فإنّها تكون بمنزلة محفظةٍ حاويةٍ لأشياء كثيرةٍ أخذتها الرواة وأوصلوها إلينا يداً بيد، فعلينا فتح باب هذه المحفظة وتحصيل العلم بما فيها من الذخائر والمطالب.
وأمّا في الفتاوى المتلقاة الّتي تكون من القسم الأوّل، فعدم الاعتناء بفتوى المشهور من القدماء فيها في غاية الإشكال؛ فإنّ ديدنهم ودأبهم في كتبهم ليس إلّا ذكر الأحكام الصادرة عنهم(علیهم السلام) من دون إعمال النظر واستعمال الاستنباط، بل لا يتجاوزون في مقام ذكر الفتوى الألفاظ الواردة في الروايات.
نعم، قد عدل الشيخ(قدس سره)((1)) عن هذه الطريقة في كتابه المبسوط، لما ذكر في أوّله من أنّه كتبه دفعاً لإيراد العامّة علينا من خلوّ فقهنا عن المسائل التفريعية وسدّ باب الاجتهاد في مذهب الشيعة، من جهة كوننا من أصحاب النصّ.
ولأجل ما ذكر من استقرار عادتهم على ذكر الأحكام الصادرة عن المعصومين(علیهم السلام) في كتبهم من دون إعمال النظر والاجتهاد، ربما يقال بالنسبة إلى بعض كتبهم الفتوائية: بكون الفتاوى المذكورة فيها عبارات الروايات وألفاظها. فلو أفتى المشهور في مسألة
ص: 200
على أحد طرفيها، بل أفتى عدّة منهم كابني بابويه والشيخين وأمثالهم، فليس للفقيه عدم الاعتناء بفتواهم والجرأة على مخالفتهم؛ فإنّ اشتهار المسألة عندهم كاشف عن وجود دليلٍ معتبرٍ، خصوصاً لو ضمّ إلى ذلك دقّتهم في الفتاوى وعثورهم على الجوامع الأوّلية الّتي ليست بأيدينا.
ومع ذلك کلّه، لا ينبغي الاغترار بمجرّد ذلك والأخذ بكلّ شهرةٍ في کلّ مسألة، بل يجب الوقوف والتأمّل عند الموارد والمسائل بحسبها، وتتبّع کلمات القوم والتدبّر فيها.
والله تعالى أعلم بالصواب، ونسأل منه التوفيق والعصمة عن السيّئات، ونعوذ به من کلّ زلّةٍ وسوءٍ في الدنيا والآخرة، ونسأله أن يحفظ ديننا، ويرزقنا العلم والعمل، ويغفر لنا ولأساتيذنا ولوالدينا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان، ويصلّي على محمدٍ وآله الطاهرين.
ص: 201
ص: 202
إعلم: أنّ دليل الانسداد على ما أفاد الشيخ(قدس سره) مركّبٌ من أربع مقدّمات.((1)) وزاد عليها المحقّق الخراساني(قدس سره) مقدّمةً اُخرى وجعلها الاُولى منها.((2)) والشيخ(قدس سره) وإن لم يجعل هذه المقدّمة من المقدّمات إلّا أنّه ذكرها في ضمن کلماته، ولعلّ وضوحها هو السبب لعدم ذكرها فى ضمن المقدّمات. وزاد المحقّق المذكور على المقدّمة الرابعة ذكر ملاك حكم العقل بلزوم الموافقة الظنّية وهو: قبح ترجيح المرجوح على الراجح. وكيف كان، لابدّ لنا من ذكر هذه المقدّمات والكلام فيها، ثم بيان أصل دليل الانسداد إن شاء الله تعالى، فنقول:
الاُولى منها: العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرةٍ فعليةٍ في ال_شريعة (وهذه هي المقدمة الّتي أضافها المحقّق الخراساني(قدس سره).
ثانيتها: انسداد باب العلم والعلمي إلى كثيرٍ من هذه التكاليف.
ثالثتها: عدم جواز إهمالها وترك التعرّض لامتثالها.
ص: 203
رابعتها:((1)) عدم وجوب الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة. كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل الجاري في کلّ مسألةٍ، ولا إلى فتوى الّذي يرى انفتاح باب العلم.
أمّا عدم وجوب الرجوع إلى الاحتياط، فلأنّه موجبٌ لاختلال النظام وتعطيل الاُمور الاجتماعية الراجعة إلى مدنيّة نوع الإنسان. ولأنّه مستلزم للعس_ر والحرج المنفيّين، وعدم وفاء عمر المجتهد باستقصاء موارد الاحتياط وتعليمه المقلّدين، فإنّ طرق الاحتياط تختلف بحسب الوجوه والاعتبارات المختلفة، مثلاً في التطهير بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ما يقتضيه الاحتياط في نفسه هو ترك التطهير به، لكن إذا لم يكن له غير هذا الماء فالأحوط التطهير به مع التطهير بالتراب. وأيضاً إذا لم يكن له غير هذا الماء ولم يجد التراب فالأحوط التطهير به وأداء الصلاة وقضاؤها مع التطهير بغيره من المياه، وهكذا. فيختلف الاحتياط في المسألة بحسب الوجوه المتصوّرة. وهذا ممّا لا يمكن استقصاؤه للمجتهد والمقلّد. هذا مضافاً إلى إجماع العلماء على عدم وجوب الاحتياط.
لا يقال: إنّ إجماعهم لو كان فليس في صورة الانسداد بل هو قائمٌ على عدم وجوبه في حال الانفتاح.
فإنّه يقال: لا فرق في ذلك بين الحالتين وإن كان ليس لهم تص_ريح بذلك في حال الانسداد، إلّا أنّ الإجماع التقديري قائمٌ على ذلك، فإنّه لا شكّ في أنّه لو سئل کلّ واحد منهم عن وجوب الاحتياط في حال الانسداد أيضاً لما أفتى إلّا بعدم وجوبه.
وأمّا الرجوع إلى الأصل الجاري في کلّ مسألةٍ، فلا يجوز لمنافاته مع علمنا الإجمالي.
وأمّا الرجوع إلى الغير، فهو أيضاً لا يجوز لكونه من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل دون العكس، كما هو واضح.
ص: 204
خامستها: أنّه بعد الحكم ببطلان لزوم الاحتياط، وهكذا الرجوع إلى الأصل الجاري في کلّ مسألة أو إلى من كان يرى انفتاح باب العلم، يستقلّ العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظنّية لتلك التكاليف المعلومة، وإلّا لزم الحكم بكفاية الامتثال الشکّي والوهمي مع التمكّن من الموافقة الظنّية، وهو باطلٌ لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
والأولى أن يقال في بيان هذه المقدّمة: بأنّه بعد بطلان الرجوع إلى الاحتياط أو الأصل الجاري أو إلى تقليد غيره ممّن يرى باب العلم أو العلمي منفتحاً، يحكم العقل بلزوم الموافقة الظنّية وعدم الاكتفاء بالموافقة الشکّية أو الوهمية لا لقبح ترجيح المرجوح على الراجح لعدم كون قبحه معلوماً، بل لاستقلال العقل باستحقاق عقاب تارك الموافقة الظنّية لو وقع في المخالفة وعدم استحقاقه في صورة ترك الموافقة الشكّية والوهمية مع وجود الإطاعة الظنّية إذا دار الأمر بين الموافقة الظنّية وبين الموافقة الشکّية والوهمية.
فإن قلت: إنّ مقتضى ذلك كما أفاد الشيخ(قدس سره) ليس إلّا عدم جواز ترك المخالفة الوهمية، إلّا أنّه لا يقتضي الاكتفاء بالموافقة الظنّية وترك الموافقة الشکّية، فلا محيص عن الاحتياط في جانب الموافقة الظنّية والشكّية وتركه بالنسبة إلى الوهمية.
قلت: نعم، ذلك صحيح إن لم تستلزم مراعاة الاحتياط بالنسبة إلى الإطاعة الشکّية العسر والحرج المنفيّين واختلال النظام مع أنّها كذلك لكثرة مواردها، هذا.
ولكن يمكن منع كون مراعاة الاحتياط في الموارد المشكوكة مستلزماً للعس_ر والحرج، كما أفاد الشيخ(قدس سره).((1))
أقول: يمكن أن يقال جواباً عن استدلالهم بدليل الانسداد لحجّية مطلق المظنّة: بأنّ
ص: 205
المراد من العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرةٍ فعليةٍ في الش_ريعة إن كان العلم بأنّ الشارع کلّفنا بتكاليف بعثيةٍ وزجريةٍ كثيرةٍ مجهولةٍ، وأراد انزجارنا عن أفعالٍ خاصّةٍ وانبعاثنا نحو أفعالٍ خاصّةٍ اُخرى بحيث لا يرضى بتركها على کلّ حال، فلازمه وجوب الاحتياط، لما قد ذكرنا سابقاً من أنّه إذا علم إجمالاً بتعلّق تكليفٍ زجريٍّ أو بعثي من جانب المولى وتردّد متعلّقه بين أمرين أو اُمورٍ فإمّا أن يكون الامتثال الإجمالي اليقيني مقدوراً للمكلّف ويكون متمكّناً من فعل کلّ واحد منها، أو لا يكون مقدوراً له. فعلى الأوّل يجب بحكم العقل الامتثال القطعيّ الإجمالي. وأمّا على الثاني فلو لم يمكن له التعرّض للامتثال أصلاً ولو بنحو الإجمال يكون في وقوعه في المخالفة القطعية معذوراً، لعدم تمكّنه لا من الموافقة القطعية ولا الاحتمالية منها؛ وإن كان متمكّناً من الموافقة الاحتمالية فيجب عليه بحكم العقل تحصيلها، فلو تركها واتّفق وقوعه في المخالفة يستحقّ العقوبة، كما أنّه لو أتى بالامتثال الاحتمالي ووقع مع ذلك في المخالفة يكون معذوراً. هذا إذا كان کلّ واحدٍ من الطرفين مساوياً.
وأما إذا كان احتمال كون التكليف في طرف أرجح، فلابدّ بحكم العقل من الإتيان بالراجح دون غيره. ولو أتى بالمرجوح ولم يأت بالراجح واتّفق وقوعه في مخالفة المولى فلا مانع من عقابه من طرف المولى عقلاً. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان العلم متعلّقاً بتكليفٍ مردّد بين امورٍ أو تكاليف مردّدةٍ بين اُمورٍ.
وإن كان المراد من العلم الإجمالي العلم الإجمالي بتعلّق إرادة الشارع بانبعاث العبد نحو هذه الأفعال الخاصّة وانزجاره عن أفعال خاصّةٍ اُخرى، لكن بقدر ما يقتض_ي طبع کلّ حكمٍ من غير عروض عارض له وطروّ طارئ عليه، كاختفائه وعدم تعلّق علمنا به تفصيلاً، فلازمه عدم وجوب الاحتياط.
نعم، يمكن أن يكون المراد العلم الإجمالي بهذه التكاليف لا على النحو الأوّل
ص: 206
ولا على النحو الثاني، بل بنحو لا يرضى الشارع بتركها بالمرّة وعدم التعرّض لامتثالها أصلاً.
وعلى کلّ حالٍ بعد تسليم وجود العلم الإجمالي بتكاليف كثيرة ووجوب التعرّض لامتثالها، وعدم وجوب الاحتياط بل عدم إمكانه في الجملة بمقتض_ى المقدّمة الرابعة، ووجوب الامتثال الإجمالي الظنّي بمقتضى المقدّمة الخامسة، نقول: إنّا بعد الورود في الفقه ومراجعتنا إلى موارد قيام الطرق والأمارات _ من ظاهر الكتاب وخبر الواحد والشهرة وغيرها _ يحصل لنا الظنّ بوجود التكاليف المعلومة بالإجمال في موارد قامت الطرق والأمارات عليها، فتجب رعاية الاحتياط في هذه الموارد.
ويمكن أن يقال: بأنّا نمنع العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرةٍ في مؤدّيات الطرق والأمارات وغيرها، بل ما يحصل للمتتبّع المتفحّص في كتب الأخبار هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرةٍ في مؤدّيات الطرق والأمارات المعتبرة دون غيرها؛ فإنّ منشأ العلم الإجمالي ليس إلّا ملاحظة تلك الروايات والآيات الدالّة على وجود أحكامٍ كثيرةٍ من الواجبات والمحرّمات، فلا منشأ للعلم الإجمالي الكبير، بل ما يحصل عند تفحّص كتب الأخبار والآيات الراجعة إلى الأحكام ليس إلّا العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرةٍ في مورد هذه الآيات والأخبار وغيرها من مؤدّيات الطرق والأمارات المعتبرة، ولازمه لزوم الاحتياط في هذا المقدار دون غيره.
ويمكن أن يقال أيضاً: بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، فإنّ بعد مراجعة كتب الأخبار وغيرها من الطرق والأمارات المعتبرة يحصل لنا العلم بوجود تكاليف كثيرةٍ في مؤدّيات هذه الطرق بمقدارٍ يمكن انطباق ما علم إجمالاً أوّلاً عليه، فينحلّ العلم الإجمالي الكبير بهذا العلم الإجمالي الصغير، ولازمه لزوم الاحتياط في موارد الطرق والأمارات المعتبرة، وعدم مانع من إجراء الاُصول في غير هذه الموارد.
ص: 207
ولا يخفى عليك: ما في هذا البيان من الفرق بينه وبين انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، من جهة نهوض الأدلّة على حجّية الظنون الخاصّة الوافية بمعظم الفقه بمقدار يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليه، فينحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشكّ البدويّ في غير مؤدّيات الظنّون الخاصّة؛ فإنّ لازم هذا البيان العمل بمقتض_ى الطرق والأمارات المعتبرة بدليلٍ خاصٍّ، ولازم البيان الأوّل هو الاحتياط. هذا کلّه بالنسبة إلى المقدّمة الاُولى والثانية.
وأمّا المقدّمة الثالثة: فما جعلوه دليلاً على عدم جواز ترك التعرّض لامتثال التكاليف من لزوم الخروج من الدين.((1)) فإن كان مرادهم كون ذلك بمنزلة كبرى کلّيّةٍ محرّمةٍ، فليس له معنى محصّلاً، لعدم كون ذلك محرّماً من المحرّمات. وإن كان مرادهم أنّ تارك التعرّض لامتثال هذه التكاليف المعلومة بالإجمال يعدّ عند العرف خارجاً من الدين، فهو يرجع إلى دعوى الضرورة على وجود التعرّض لامتثال الأحكام.
وأمّا المقدّمة الرابعة: ففي الإجماع التقديريّ المدّعى لعدم وجوب الاحتياط التامّ:((2)) أنّ الإجماع يجب أن يكون مدركاً لحصول العلم، وفي ما نحن فيه جعل العلم مدركاً لتحقّق الإجماع. ودعواه على هذا النحو يرجع إلى دعوى وضوح ذلك بحيث لو سئل من المصنّفين والعلماء لأجابوا كذلك، وهذا ليس استدلالاً بالإجماع، بل هو استدلال بالضرورة والوضوح، ويمكن إنكاره من جانب الخصم.
وأمّا الاستدلال له بأنّ الاحتياط يوجب اختلال النظام. فبالنسبة إلى الاحتياط التام لا کلام فيه. وأمّا فيما لا يوجب ذلك، فقد استدلّ الشيخ(قدس سره) بقاعدة نفي العس_ر
ص: 208
والحرج((1))، فإنّ المستفاد من أدلّتها عدم وجود العسر والحرج في الإسلام، ولازم ذلك عدم وجود حكم يستلزم الحرج والع_سر في الإسلام ووجود أحكام لولاها تحقّق العسر والحرج.
وأمّا المحقّق الخراساني(قدس سره) فاختار أنّ المستفاد من أدلّتها وكذا أدلة نفي الض_رر إنّما هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع،((2)) فيكون مفادها نفي الحكم المترتّب على موضوع قد يكون ضرريّاً أو حرجيّاً وقد لا يكون بلسان نفي هذا الموضوع.
ولقائل أن يقول: إنّ أدلتها لو كانت في مقام نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لكان مفادها نفي الحكم المترتّب أو المترقّب لموضوع العسر والحرج بلسان نفي أصل العس_ر والحرج، وفساده واضح.
ولا يقاس المقام بقوله في حديث الرفع: «ما استكرهوا عليه، وما اضطرّوا إليه»، فإنّ حرف الموصول للإشارة إلى صلتها. وقد قلنا بأنّ الفرق بين «ما» الموصولة والموصوفة هو: أنّ الاُولى معناها ما يعبّر عنه بالفارسية ب_ «آن چيز» والثانية ب_ «چيزى». وكيف كان، ليس ما نحن فيه من قبيل رفع ما استكرهوا عليه وما اضطرّوا إليه.
فالتحقيق: أنّ ما أفاده الشيخ(قدس سره) هو الحقّ والأظهر، كما لا يخفى. هذا کلّه فيما يتعلّق بالمقدّمة الاُولى والثانية والثالثة (والرابعة على مختار المحقّق الخراساني(قدس سره)).
وأمّا الكلام في المقدمة الرابعة (والخامسة على مختار المحقّق المذكور)، فنقول _ بعدما بيّناه من انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير _ : لا حاجة إليها لوجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الصغير أي مؤدّيات الطرق والأمارات الخاصّة.
وهكذا الكلام بالنسبة إلى المقدّمة الخامسة، ولا حاجة في الحكم بلزوم الإطاعة
ص: 209
الظنّية وعدم الاكتفاء بالشكّية والوهمية بقبح تقديم المرجوح على الراجح؛ فإنّ نفس كون العبد مستحقّاً للعقاب _ في صورة الأخذ بالتكاليف المشكوكة والموهومة دون المظنونات _ من المستقلّات العقلية، فلا يحتاج استحقاقه للعقاب إلى قاعدة اُخرى تكون ملاكاً لحكم العقل، لعدم الفرق بين المقام وبين سائر المستقلّات العقلية.
هذا مضافاً إلى أنّ قبح تقديم المرجوح على الراجح لو كان من المستقلّات العقلية فإنّما هو في قبح تقديم المرجوح الخارجي على الراجح الخارجي، كما إذا أمر المولى عبده بإعطاء درهمٍ لشخصٍ وتردّد بين عمرو الفاضل العادل وبين زيدٍ الّذي ليس بعالمٍ، فأعطى زيداً وفضّل المفضول على الفاضل، وأمّا تقديم المرجوح الذهني على الراجح الذهني مثل ما نحن فيه، فليس قبيحاً.
وكيف كان، لا حاجة إلى ذلك بعد استقلال العقل بصحّة مؤاخذة المولى عبده على المخالفة في صورة الاكتفاء بالموافقة الوهمية أو الشكّية وترك الإطاعة الظنّية.
ثم اعلم: أنّه على تقدير تمامية المقدّمات، فليس مقتضاها إلّا تبعيض الاحتياط؛ لكون العلم الإجمالي منجّزاً ومقتضياً للاحتياط في جميع الأطراف إلّا أنّ محذور اختلال النظام ولزوم العسر والحرج المنفيّين صار سبباً لرفع اليد عن الاحتياط التامّ وتبعيضه في المظنونات في الموارد الّتي قامت الطرق والأمارات على التكليف فيها بناءً على انحلال العلم الإجمالى الكبير بالصغير، أو مطلق المظنونات لو لم نقل بانحلاله، لا حجّية المظنّة كالقطع، لعدم إفادة المقدّمات حجّية الظنّ رأساً كالعلم.
فما ربما يدّعى أنّه يستفاد من بعض کلمات الشيخ(قدس سره) من كون مفاد دليل الانسداد _ على تقدير تماميته _ حجّية المظنة، وأمّا لو قلنا بعدم تمامية دلالته على رفع اليد عن الاحتياط التامّ إلّا بقدر ما يوجب العسر والحرج لا مطلقاً، فيجب تبعيض الاحتياط في جانب المشكوكات أيضاً.
ص: 210
فليس بظاهره مستقيماً؛ لأنّ عدم رفع اليد عن الاحتياط رأساً لازم العلم الإجمالي من غير فرق بين القول بلزوم العس_ر والحرج واختلال النظام في مراعاته في الموارد المشكوكة والموهومة أو في مراعاته في الموارد الموهومة خاصّةً، فتدبّر.
تقريرٌ آخر لدليل الانسداد((1))
إعلم: إنّ الّذي ينبغي أن يقال: إنّ تقرير دليل الانسداد بهذا النحو الّذي استقرّت عليه عادة متأخّري المتأخّرين ليس مناسباً للش_ريعة الكاملة الإسلامية، وإنّما يكون مناسباً لشريعةٍ تكون جميع أحكامها راجعة إلى الاُمور العباديّة وما هو وظيفة العبد فيما بينه وبين خالقه، كش_ريعة المسيح الّتي ليست فيها أحكام راجعةٌ إلى السياسات والانتظامات وقطع المحاكمات والمنازعات وغيرها من شؤون الحياة الاجتماعية والانفرادية؛ فإنّ المقدّمة الثانية _ وهي عدم جواز إهمال تلك التكاليف المعلومة بالإجمال وترك التعرّض لامتثالها _ لا تناسب إلّا شريعةً كانت جميع أحكامها أو أكثرها راجعاً إلى العبادات، لا مثل الش_ريعة الإسلامية الجامعة الكافلة لجميع ما يحتاج إليه نوع الإنسان في أمر معاشه ومعاده وسياساته ومعاملاته وغيرها، فإنّ أكثر تلك الأحكام ليست من الاُمور العبادية المحضة حتى نجعل أنفسنا بالنسبة إليها كالرهبان ونستدلّ لعدم جواز ترك التعرّض للامتثال.
وهكذا المقدّمة الثالثة _ وهي استلزام الاحتياط والامتثال الإجمالي لل_عسر والحرج مع وجوبه لولا استلزامه لهما _ فإنّه لا معنى للاحتياط في الأحكام الراجعة إلى المعاملات والمرافعات وإجراء الحدود والديات والقضاء وغيرها.
ص: 211
ولذا ليس في لسان من تقدّم على المحقّق جمال الدين الخوانساري(قدس سره) ذكر هذه المقدّمات((1)). فما هو المناسب لشريعتنا في تقريره، وهو مذكور في کلام من تعرّض لهذا الدليل قبل المحقّق المذكور: أنّ مقت_ضى آية النفر وأشباهها من الآيات كآية الكتمان وغيرها، والأخبار الكثيرة: وجوب تعلّم الأحكام وتعليمها ووجوب الاستفتاء والإفتاء والقضاء، وأنّ صاحب الش_ريعة لم يجعل الناس في اُمورهم الدنيوية والاُخروية مطلق العنان ولم يرض بفوت فوائد أحكامه عن الناس، بل أوجب عليهم التعليم والتعلم حفظاً لتلك الفوائد وإيصالها للناس، فإذا انسدّ باب العلم بهذه الأحكام أو بطرقها المعلومة حجّيتها من جانب الش_رع، فإمّا أن يقال بالاكتفاء بالأحكام المعلومة المقطوعة المسلمة، فهو باطل بص_ريح هذه الآيات والروايات كقوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «بعثت أنا والساعة كهاتين»((2)) الدالّة على بقاء دين الإسلام إلى يوم القيامة، وغيرها من الروايات، فإنّ الاكتفاء بهذا المقدار القليل من الأحكام مرغوب عنه قطعاً لاستلزامه فوت جلّ فوائد الأحكام لو لم نقل بفوات كلّها عن الناس. وإمّا أن يقال بتحصيل تلك الأحكام ووجوب تعليمها وتعلّمها على نحو لا يكون القول به والإفتاء به قولاً بغير علمٍ، فهو لا يمكن إلّا من الطرق المتعارفة المتداولة الّتي لا يكون الإفتاء وتعليم الأحكام فيها إفتاءً بغير علمٍ لإطلاق العلم على مثل هذا في القرآن والأخبار كقوله تعالى: ﴿أَوْأَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾.((3))
ص: 212
فظهر أنّ مع انسداد باب العلم ووجوب التفقّه والتعلّم وحرمة الكتمان ووجوب الإفتاء وبيان حكم الله لابدّ من الرجوع إلى هذه الطرق المتداولة والقول بحجّيتها عند الشارع العالم ببقاء أحكامه إلى يوم القيامة.
والحاصل: أنّ تقرير دليل الانسداد على النحو المذكور في کلمات من تأخّر عن المحقّق الخوانساري ليس مناسباً للش_ريعة الإسلامية، وليس الكلام في أنّ للشارع أحكاماً فعلية ليس لنا إليها طريقٌ حتّى تصل النوبة إلى مقام الامتثال ووجوب الامتثال الإجمالي والاحتياط. بل ما هو مناسبٌ للشريعة الإسلامية الحاوية للأحكام التكليفية والوضعية بكثرتها الراجعة إلى جميع الشؤون الحياتية ويستفاد من كلمات من تعرّض لدليل الانسداد ممّن تقدّم على المحقّق الخوانساري(قدس سره) هو: أنّا إمّا أن نقول بفعلية الأحكام الش_رعية وإرادة الشارع انتفاع عبيده بفوائد هذه الأحكام أم لا، ولا سبيل إلى الثاني، فعلى الأوّل فإمّا أن نقول بفعلية خصوص ما قام عليه الطريق القطعي دون غيره أم لا، ولا سبيل إلى الأوّل لكونه مؤدّياً إلى فوت فوائد هذه الأحكام الكثيرة في جلّ أبواب الفقه ونقض غرض الشارع وهو انتظام اُمور الناس بسبب الرجوع إلى هذه الأحكام، ولذا أوجب على الناس التفقّه والتعليم وحرّم الكتمان، وعلى الثاني لابدّ أن يكون الطريق إلى إحرازها بعد انسداد باب العلم إلى جلّ الأحكام أو بطرقها المعلومة حجّيتها عند الشارع: الطرق المتعارفة الظنّية دون غيرها، لدوران الأمر بين فعلية ما قام عليه الطريق الظنّي ومتابعة الظنّ أو متابعة الوهم، ولا شكّ في كون العقل قاطعاً بحجّية الظنّ وعدم جواز الاكتفاء بالوهم.
ولا يخفى عليك: أنّ مع هذا البيان لا معنى للمقدّمة الثالثة وهي إبطال العمل بالبراءة، ولا المقدّمة الرابعة وهي إبطال الاحتياط، ولا معنى لدوران الأمر بين الامتثال الظنّي والشكّي والوهمي كما ذكر في المقدّمة الخامسة، فإنّه إنّما يتصوّر بالنسبة إلى جميع الأحكام بعد عدم إمكان الاحتياط والتعرّض للامتثال الشکّي والوهمي والظنّي.
وأمّا على ما ذكرنا فيدور الأمر في کلّ واقعةٍ بين الأخذ بالظنّ أو الوهم، فالمفتي والقاضي
ص: 213
والسائس في مقام الفتوى والقضاء وإجراء السياسة يدور أمره بين الأخذ بالطريق الظنّي أو الوهمي. ولا ريب في أنّ العقل قاطع بفعلية الحكم إذا قام عليه الطريق الظنّي.
وأيضاً لا حاجة إلى المقدّمة الاُولى _ وهي دعوى العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة _ لكون احتمالها أيضاً منجّزاً، هذا.
وهنا ينبغي التنبيه على اُمور:
التنبيه الأوّل: هل مقتض_ى التقرير الثاني لدليل الانسداد حجّية الظنّ من باب الكشف ومقام إحراز التكليف أو الحكومة ومقام الامتثال.
يمكن أن يقال: إن كان المراد من الكشف أنّ الشارع جعل الظنّ حجّة تأسيساً لإحراز الواقع، فليس لازم هذا البيان حجّيته كذلك.
وإن كان المراد أنّه بعد بقاء فعلية الأحكام وعدم اختصاص فعليتها بصورة قيام الطريق القطعي على الحكم ووجوب الإفتاء والقضاء ورفع المخاصمات وإجراء السياسات، يقطع العقل بحجّية الظنّ وإمضاء حجيته للكشف عن الواقع من طرف الشارع من الصدر الأوّل. لا يقال: إنّ الانسداد في الأعصار المتأخّرة لا يلازم الانسداد في عص_ر الحضور والصدر الأول.
فإنّه يقال: لا فرق في الانسداد بين الأزمنتين، لو لم نقل بأنّ الوصول إلى الأحكام في زماننا أسهل من الأزمنة الماضية.
ثم إنّه لا يأتي على البيان الثاني في ردّ القول بالكشف ما أفاده الشيخ(قدس سره) في ضمن بيان المقدّمات الّتي ذكرها لدليل الانسداد:((1)) أنّ وجوب الامتثال وكيفيّته ليس أمره بيد
ص: 214
الشارع بل العقل حاكمٌ بوجوب امتثال أوامر المولى على العبد، وتقدّم الإطاعة القطعية التفصيلية على الإجمالية وهي على الظنّية التفصيلية وإن كان يحتمل عدم تقدّمها عليها وكونها في عرضٍ واحدٍ، أو تقدّم هذه عليها وهما على الإطاعة الاحتمالية.
والمتراءى منه في ضمن کلماته كون نتيجة دليل الانسداد الحكومة لا الكشف.
وأفاد لبطلان كون النتيجة هي الكشف وجوهاً ثلاثة،((1)) نشير إليها في التنبيه الثالث.
والغرض هنا أنّ ما ذكره من كون العقل حاكماً بوجوب إطاعة المولى، لا ريب فيه؛ فإنّه ليس للإطاعة نفسيّةٌ واستقلالٌ حتى تكون موضوعاً للوجوب، فإنّها أمرٌ منتسبٌ إلى أمر المولى أو نهيه، وعبارةٌ عن إتيان الفعل بداعي أمر المولى، ومعه كيف يمكن الأمر بها ليصير ذلك الأمر داعياً للمكلّف، فيكون صيرورة هذا الأمر داعياً له معدماً لموضوع الإطاعة الّتي هي موضوع لذلك الأمر الثانوي. وأيضاً يحتاج في إثبات وجوب إطاعة الأمر الثاني إلى أمرٍ آخر بإطاعة هذا الأمر إلى أن يتسلسل، فيلزم أن يكون العاصي بترك الصلاة مثلاً مرتكباً لمعاصي كثيرةٍ.
والحاصل: أنّه لا معنى للأمر بالإطاعة مولوياً. نعم، لا مانع منه إرشاداً كقوله سبحانه وتعالى: ﴿أَطيِعُوا الله﴾.((2)) ومن هنا يظهر بطلان القول بكلّية قاعدة الملازمة وهي: «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع».
فعلى هذا، ليس الحاكم بلزوم الامتثال إلّا العقل، وليس للشرع دخلٌ في ذلك. وإذا كان هو الحاكم بأصل لزوم الامتثال وقبح ترك إطاعة أمر المولى، فهو الحاكم أيضاً في كيفيّة الامتثال ومراتبه.
ولكن أنت خبيرٌ بأنّ هذا البيان _ وإن يقال قبال تقرير دليل الانسداد على ما ذكره
ص: 215
المتأخّرون والقول بأنّ نتيجته الكشف _ لا يجيء على الوجه الصحيح _ الّذي قرّرناه في بيان دليل الانسداد _ فإنّا قد قلنا بأنّ الأحكام الش_رعية إمّا أن تكون فعليةً مطلقاً بمعنى: أنّ الشارع أراد ترتب منافعها عليها، وكونها مرجعاً للمكلفين في جميع اُمورهم، وملاكاً وميزاناً لدفع الاختلافات والمخاصمات، ووصول کلّ ذي حقّ إلى حقّه، ومبنى لحفظ النظام، وغيرها من الفوائد الدنيوية والاُخروية مطلقاً، أي ولو لم يكن إليها طريقٌ. وإمّا أن يقال بفعليّتها مع وجود الطريق إليها. ولا سبيل إلى الأوّل.
وعلى الثاني: فإمّا نقول بأنّ الشارع أراد انتفاع المکلّفين بهذه الأحكام إذا قام إليها طريقٌ قطعيٌ وثبت بالعلم والقطع، أم لا.
فعلى الأوّل، يلزم حرمانهم عن فوائد جلّ الأحكام وتفويت منافعها، ومن المقطوع أنّه لا يريد ذلك، فيدور الأمر بين أن يكون المرجع هو الطرق الظنّية المتعارفة، أو الرجوع إلى العقل، ولا ريب في تعيّن الأوّل. فإنّ الرجوع إلى العقل وكونه ملاكاً في استنباط الأحكام بالخرص والتخمين والاستحسان أمرٌ مرغوبٌ عنه وقبيحٌ شرعاً وعقلاً، قال الله تعالى: ﴿وَإنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ الله إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإنْ هُمْ إلَّا يَخْرُصُونَ﴾.((1))
فلا مجال لتطرّق الاستحسانات والتخمينات العقلية في استنباط الأحكام الإلهية، فإنّ العقل قاصر عن الإحاطة بجميع المصالح والمفاسد، وإدراك تمام ملاكات الأحكام ومناطاتها. ألا ترى أنّ العالم الخبير في کلّ فنٍّ يرى إحالة إدراك بعض المطالب العالية الغامضة إلى الجاهل غير المطّلع على هذا الفنّ قبيحاً، ويرى حكومته وإظهار رأيه رجماً بالغيب والخرص والتخمين. فكيف إذا كان ذلك الأحكام الإلهية
ص: 216
الصادرة من منبع الوحي الكافلة لجميع مصالح البشر، وما لعقل الإنسان من الشأن والقدر حتى يكون له شأنية الردّ والقبول في ذلك. ولو كانت له هذه الأهلية فلا حاجة إلى بعث الأنبياء بالشرائع والأحكام.
فعلى هذا، ليس مفاد دليل الانسداد أزيد من حجّية الطرق الظنّية المتعارفة وإمضائها من قبل الشارع. وليس مرادهم من الاستدلال به إثبات مطلق الظنّ بحيث يكون واجباً على کلّ من يتصدّى للاستنباط والاجتهاد المراجعة إلى قلبه، فإن وجد منه الظنّ إلى طرفٍ دون آخر يأخذ بالطرف الراجح في نظره.
ومن هنا يظهر: أنّ إخراج الظنّ القياسي من تحت دليل الانسداد ليس محتاجاً إلى تجشّم الاستدلال؛ فإنّه خارج من الأوّل، لعدم كون المرجع العقل حتى تكون حجّية الظنّ القياسي داخلة، ولعدم كونه من الطرق الظنّية المتعارفة، وإنّما استند إليه العامّة لمكان قلّة الروايات المرويّة عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) في الأحكام من طرقهم _ فإنّها لا تزيد عن أربعمائة حديث _ وتركهم التمسّك بقول العترة الّتي اُمروا بالتمسّك بها، فألجأهم ذلك إلى العمل بالقياس وهو: استفادة حكم ما لا رواية فيه عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عن حكم أشباهه ونظائره ممّا ثبت حكمه عندهم بروايةٍ. وحيث إنّ ذلك أيضاً لا يفي باستنباط جميع الأحكام الراجعة إلى أبواب الفقه أضافوا على العمل بالقياس العمل بالاستحسان فيما ليس له شبيه ولا نظير في الروايات. وحيث إنّ العمل بالقياس ليس من الاستحسان المحض ورفع اليد عن النقل بالمرّة بزعمهم كان العامل بالقياس بينهم أكثر من العاملين بالاستحسان وإن كان لا فرق بينهما في البطلان لما ذكرنا من أنّ ذلك ليس من شأن العقل، وعدم اطّلاعنا على ملاكات الأحكام الش_رعية والمصالح والمفاسد بحسب الموارد المختلفة الّتي لا يعلمها كما ينبغي إلّا الله علّام الغيوب. فافهم واغتنم ما في هذا التنبيه.
ص: 217
قد ظهر ممّا ذكرنا في تقرير دليل الانسداد وما ذكرنا في ضمن التنبيه السابق: أنّه ليس مفاد هذا الدليل طريقية مطلق الظنّ في إحراز الحكم، بمعنى أنّ کلّ أحد يرجع في إحرازه إلى نفسه ويأخذ بكلّ طرفٍ يكون راجحاً عنده مطلقاً. ولا طريقية مطلق الطريق الظنّي، ولا مطلق النقل من الشارع. بل المستفاد منه حجّية النقل الّذي تعارف الأخذ به بين العقلاء.
فإنّ القول بكون النتيجة طريقية مطلق الظنّ، مخالفٌ لما يستفاد من آية النفر وغيرها ممّا يدلّ على وجوب الفحص عن الأحكام ووجوب تحصيلها. مضافاً إلى أنّ نتيجة هذا الدليل ليست الرجوع إلى حكم العقل والاستحسانات والأقيسة.
وبالجملة: فلا يستفاد منه أزيد من طريقية النقل الّذي تعارف بين العقلاء الأخذ به؛ فإنّه بعد عدم كفاية النقل القطعي في إحراز الأحكام لابدّ من التنزّل إلى النقل الظنّي المتعارف الأخذ به عند العقلاء، كما لا يخفى.
فعلى هذا، لا حاجة لإخراج القياس عن نتيجة دليل الانسداد إلى بيان الوجوه السبعة. وقد ذكرنا في ذيل التنبيه السابق ما يناسب ذكره في ما يرجع إلى هذا التنبيه مفصّلاً.
لا يخفى عليك: أنّ ما ذكرناه في تقرير دليل الانسداد مناسبٌ لما ذكره صاحب المعالم(قدس سره)، فإنّه في مقام ذكر أدلّة حجّية خبر الواحد جعل الدليل الرابع منها دليل الانسداد.((1)) فإنّه لا يستفاد منه أكثر من حجّية الخبر وإن كان يظهر من بعض عباراته كون الظنّ مرجعاً، فإنّه أفاد في ما إذا دار الأمر بين الأخذ بالخبر المفيد للظنّ والأخذ بالظنّ الأقوى منه بلزوم الأخذ بالظنّ الأقوى.
ص: 218
ولكنّه ظهر لك ممّا فصّلناه _ من عدم كون الأحكام فعلية مطلقاً بل ومع قيام الطريق القطعي إليها، وأنّه لا تفاوت في انسداد باب العلم بين زماننا وعص_ر النبيّ والأئمّة(علیهم السلام) والأعصار المتقدّمة على عصرهم لو لم نقل بانفتاحه في زماننا بالنسبة إلى الأزمنة السابقة لسهولة العثور على الروايات بسبب جمعها مع الترتيب والتنظيم في الكتب المدوّنه بعدما لم تكن كذلك وكانت متفرّقة عند الرواة _ : أنّ الشارع أراد فعليّة أحكامه وانتفاع عبيده منها من طريق النقل الموجب للظن النوعي _ المعتبر عند العقلاء الاتّكال عليه _ لا مطلق النقل ولو لم يكن ناقله موثّقاً، أو ضابطاً، أو ولو كان ناقله ممّن يحصل له العلم والظنّ بما لم يحصل لغالب الناس، ولا مطلق الظنّ ولو كان حاصلاً من الاستحسانات والقياسات والجفر والرمل والرؤيا، بل الظنّ الموجب للظنّ النوعي الّذي لا يعدّ العامل به عاملاً بغير العلم بل يعدّ أنّه عامل بالعلم، كما اُطلق العلم على مثل هذا الظنّ في سورة الأنعام: ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛((1)) وفي آية اُخرى: ﴿أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾؛((2)) فإنّ المراد بالعلم القابل للإخراج والعلم المأثور هو النقل المعتبر.
وممّا ذكرنا يظهر ما في کلام الشيخ(قدس سره) من أجوبته الثلاثة عن كون نتيجة دليل الانسداد الكشف.((3))
أمّا وجهه الأوّل، وهو: أنّ المقدّمات المذكورة لا تستلزم جعل الظنّ _ مطلقاً أو بش_رط حصوله من أسباب خاصّة _ حجّةً من قبل الشارع، لجواز أن لا يجعل الشارع طريقاً للامتثال.
ص: 219
ففيه: أنّه إن أراد _ بجواز أن لا يجعل الشارع طريقاً للامتثال _ جعل الطريق تأسيساً، فهو مسلّمٌ. وإن أراد جوازه حتّى إمضاءً، فممنوعٌ.
وأمّا الوجه الثاني، وهو: أنّه على مبنى الكشف لا يجب أن يكون الظنّ حجّة بجعل الشارع، بل من الممكن جعله طريقاً آخر غير مفيدٍ للظنّ فمن أين ثبت جعل الظنّ حجّة من قبله؟
ففيه: أنّه بعد القطع بعدم جعله طريقاً غير هذه الطرق المتعارفة، لا مجال للاعتناء بهذا الاحتمال.
وأمّا الوجه الثالث، وهو: أنّ تعيين بعض الظنّون من بينها، كالظنّ الحاصل من النقل، لا يتمّ إلّا بضميمة الإجماع، مع أنّ هذا خلاف تسمية هذا الدليل بالدليل العقلي.
وفيه: أنّه ليس في هذا كثير إشكالٍ، فبعد تمامية الدليل سمّه ما شئت.
والحاصل: أنّ نتيجة دليل الانسداد هي: كون النقل الّذي يعتمد عليه العقلاء مرجعاً في إحراز الأحكام، كما مرّ ذكره في التنبيه الثاني. والقول برجوع هذا الدليل أيضاً إلى بناء العقلاء قريبٌ جدّاً. نعم، يوجد فرقٌ بينهما وهو أنّ في تقرير دليل العقل لا تذكر مقدّمة انسداد باب العلم إلى الأحكام، لكونها مركوزة في أذهان العقلاء وابتناء حكمهم على حجّية خبر العادل عليها، وفي دليل الانسداد يص_رّحون بتلك المقدمة، وهذا لا يمنع من رجوع هذا الدليل إلى بناء العقلاء. فلا مانع من أن نقول برجوع جميع الأدلّة إلى بناء العقلاء. أمّا الآيات من أنّ واحدة منها لا تدلّ على حجّيته تأسيساً. وهكذا حال الأخبار. وأمّا الإجماع، فقد ظهر أنّ الإجماع القولي ليس في البين، وأنّ ما هو في البين هو الإجماع العملي واستقرار طريقتهم على العمل بالخبر، ولا ريب في أنّ ذلك ليس بما أنّهم مسلمون أو فقهاء بل بما أنّهم عقلاء، كما هو دأب أهل سائر الفرق والمذاهب.
ص: 220
لا يخفى عليك: أنّهم اختلفوا في أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هي حجّية الظنّ بطريقيّة الطريق أو حجّية الظنّ بالواقع أو حجّية کليهما.((1))
فاختار الأوّل بعضهم كالشيخ محمد تقي صاحب الحاشية((2)) وأخيه المحقّق صاحب الفصول((3)) قدّس سرّهما. واختار الثاني شريف العلماءرحمه الله. والشيخ وغيره اختاروا الثالث.((4))
ولكن بعد ملاحظة ما تلوناه عليك لا وقع لهذا الاختلاف ويسقط البحث رأساً، فإنّ مقتضى ما ذكر حجّية الظنّون النقلية الّتي توجب الظنّ عادةً، وليس في حجّية الظنّ تأسيساً من الشارع وجعلاً مستقلّا، لمعلومية أنّ ذلك لو كان لنقل إلينا لتوفّر الدواعي على نقله وكونه من أهمّ ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم وعدم وجود سببٍ لاختفائه، وهذا بخلاف إيكال الناس إلى حالهم وما هو المتعارف بينهم من الأخذ بالطرق النقلية، فإنّ إمضاء ما استقرّت عليه طريقتهم ليس أمراً نقلياً بل هو أمرٌ يعرف من بناء المسلمين بما استقرّت عليه سيرتهم من الأخذ بالظنون النقلية ومعاملتهم في ما هو بينهم وبين صاحب الشرع بحسب ارتكازهم على نحو ما هو المتعارف بينهم بالنسبة إلى سائر الموالي والعبيد. فعلى هذا، لا مجال للاختلاف المذكور.
إعلم: أنّ الطرق النقلية الظنّية المتعارفة منحصرة في الخبر، بل حجّيتها نتيجة جميع
ص: 221
المباحث المذكورة في مبحث حجّية الظنّ. فإنّ الإجماع المنقول لو قيل بحجّيته فإنّما هو باعتبار كشفه ونقله عن قول المعصوم(عَلَيْهِ السَّلاَمُ). وكذا الشهرة إنّما تعتبر لكونها سبباً للقطع بوجود خبر معتبر مذكور في الجوامع الأوّلية.
نعم، مبحث حجّية الظواهر ليس راجعاً إلى مبحث الخبر.
وربما يقال: بأنّ استقرار طريقة العقلاء على الأخذ بظواهر الكلمات أقوى من الأخذ بالطرق النقلية، خصوصاً هذه الطرق النقلية الّتي كثرت الوسائط فيها بين الناقل والمنقول عنه خصوصاً في أعصارنا، فلو لم نقل بعدم استقرار طريقتهم على الأخذ بمثل هذه الطرق لا مجال لإنكار ضعف استقرار طريقتهم على ذلك.
ولا يخفى عليك: أنّ هذا الكلام بظاهره متينٌ لولا ما بيّناه في دليل الانسداد من كون حجّية هذه الطرق النقلية _ وإن بلغت الوسائط ما بلغت _ هو مقتضى وضع الش_ريعة الكاملة الإسلامية وبقاء أحكامها إلى يوم القيامة لقوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين»،((1)) مع عدم وجود طريق متعارف عند العقلاء غير النقل.
هذا تمام الكلام في دليل الانسداد. ولا يخفى عليك أنّا وإن ابتعدنا عمّا هو المذكور في کلمات المتأخّرين وخالفنا مسلكهم، إلّا أنّه لا اعتناء به بعد قربنا إلى ما هو المقصود من دليل الانسداد في المقام.
والحمد لله أوّلاً وآخراً واُصلّي على رسوله وآله الهادين المعصومين. وأسأله أن يوفّقنا لصالح الأعمال، وما يوجب رفع الدرجات وحطّ السيّئات وغفران الخطيئات. اللّهمّ اغفر لنا ولوالدينا ولمعلّمينا وللمؤمنين والمؤمنات.
ص: 222
ص: 223
1. القرآن الکریم.
2. الإبهاج في شرح المنهاج، السبکي، عليّ بن عبد الکافي (م. 756ق.).
3. الاحکام في اُصول الأحکام، الآمدي، عليّ بن محمد (م. 631ق.)، الریاض، المکتب الإسلامي، 1387ق.
4. الاختصاص، المفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، قم، مؤسّسة الن_شر الإسلامي، 1414ق.
5. إرشاد الفحول إلی تحقیق الحقّ من علم الاُصول، الشوکاني، محمد بن عليّ (م. 1250ق.).
6. الاستبصار، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1390ق.
7. اُسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثیر الجزري، عليّ بن محمد (م. 630ق.)، طهران، مؤسّسة إسماعیلیان.
8. إشارات الاُصول، الکلباسي، محمد إبراهیم بن محمد حسن (م. 1262ق.)، طهران، الطبعة الحجریة، 1245ق.
9. الإشارات والتنبیهات، ابن سینا، حسین بن عبد الله (م. 428ق.)، قم، ن_شر البلاغة، 1383ش.
ص: 224
10. الإصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (م. 852ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1415ق.
11. اُصول السرخس_ي، السرخس_ي، محمد بن أحمد (م. 483ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1414ق.
12. اعتقادات فرق المسلمین وال_مشرکین، الفخر الرازي، محمد بن عمر (م. 606ق.)، القاهرة، مکتبة مدبولي، 1413ق.
13. الأمالي، الصدوق، محمد بن علي (م. 381ق.)، قم، مؤسّسة البعثة، 1417ق.
14. الأمالي، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، قم، دار الثقافة، 1414ق.
15. الأمالي، المفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، بیروت، دار المفید، 1414ق.
16. أمان الاُمة من الضلال والاختلاف، الصافي الگلپایگاني، لطف الله، قم، المطبعة العلمیة، 1397ق.
17. الانتصار، الشریف المرتضی، عليّ بن حسین (م. 436ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1415ق.
18. أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، المفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، بیروت، دار المفید، 1414ق.
19. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(علیهم السلام)، المجل_سي، محمد باقر (م. 1111ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1403ق.
20. البدایة والنهایة، ابن کثیر، إسماعیل بن عمر (م. 774ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1408ق.
21. البرهان في تفسیر القرآن، البحراني، السّید هاشم الحسیني (م. 1107ق.)، طهران، مؤسّسة البعثة، 1416ق.
ص: 225
22. بشارة المصطفی(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لشیعة المرتضی(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، الطبري، محمد بن أبي القاسم (م. 525ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1420ق.
23. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد(علیهم السلام)، الصفّار، محمد بن حسن (م. 290ق.)، طهران، مؤسّسة الأعلمي، 1404ق.
24. تاریخ المدینة المنوّرة، ابن شبة النمیري، عمر بن شبة (م. 262ق.)، قم، دار الفکر، 1410ق.
25. تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي، أحمد بن عليّ (م. 463ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1417ق.
26. تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، عليّ بن حسن (م. 571ق.)، بیروت، دار الفکر، 1415ق.
27. تحقیق ما للهند، البیروني، أبو ریحان محمد بن أحمد (م. 440ق.)، بیروت، عالم الکتب، 1403ق.
28. التذکرة باُصول الفقه، المفید، محمد بن محمد (م.413ق.)، بیروت، دار المفید، 1414ق.
29. التعریفات، الجرجاني، علّي بن محمد (م.816ق.)، طهران، منشورات ناصر خسرو، 1412ق.
30. تفسیر الصافي، الفیض الکاشاني، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، طهران، مکتبة الصدر، 1416ق.
31. تفسیر العیّاشي، العیّاشي، محمد بن مسعود (م. 320ق.)، طهران،المکتبة العلمیة الإسلامیة.
32. تفسیر القمّي، الفیض الکاشاني، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، طهران، منشورات الصدر، 1415ق.
ص: 226
33. تمهید القواعد، الشهید الثاني، زین الدین بن عليّ العاملي (م. 965ق.)، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، 1416ق.
34. التوحید، الصدوق، محمد بن عليّ (م.381ق.)، قم، مؤسّسة الن_شر الإسلامي، 1398ق.
35. تهذیب الأحکام، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1364ش.
36. تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن عليّ (م. 852ق.)، بیروت، دار الفکر، 1404ق.
37. جامع الاُصول في أحادیث الرسول، ابن الأثیر، مبارك بن محمد (م. 606ق.)، بیروت، دار الفکر، 1403ق.
38. جامع البیان في تفسیر القرآن، الطبري، محمد بن جریر (م. 310ق.)، بیروت، دار المعرفة، 1412ق.
39. الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، السیوطي، جلال الدین (م. 911ق.)، بیروت، دار الفکر، 1401ق.
40. جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، ابن الدمشقي، محمد بن أحمد (م. 871ق.)، قم، مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، 1415ق.
41. حاشیة کتاب فرائد الاُصول، الخراساني، محمد کاظم (م. 1329ق.)، قم، مکتبة بصیرتي.
42. خصائص أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب7، النسائي، أحمد بن شعیب (م. 303ق.)، طهران، مکتبة النینوی الحدیثة.
43. الخصال، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، قم، مؤسّسة ال_نشر الإسلامي، 1403ق.
ص: 227
44. الخلاف، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، قم، مؤسّسة الن_شر الإسلامي، 1414ق.
45. الدرّ المنثور في التفسیر بالمأثور، السیوطي، جلال الدین (م. 911ق.)، قم، مکتبة المرعشي النجفي، 1404ق.
46. درر الفوائد، الحائري الیزدي، عبد الکریم، قم، مؤسّسة الن_شر الإسلامي، 1408ق.
47. الدرر النجفیة، البحراني، یوسف بن أحمد (م. 1186ق.)، بیروت، دار المصطفی لإحیاء التراث، 1423ق.
48. الذریعة إلی اُصول الشریعة، الشریف المرتضی، عليّ بن حسین (م. 436ق.)، طهران، جامعة طهران، 1346ق.
49. رجال ال_کشّي، ال_کشّي، محمد بن عمر (م. قرن4)، مشهد، جامعة مشهد، 1409ق.
50. رجال النجّاشي، النجاشي، أحمد بن علي (م. 450ق.)، قم، مؤسّسة الن_شر الإسلامي، 1416ق.
51. رسائل الشریف المرتضی، الشریف المرتضی، عليّ بن حسین (م. 436ق.)، قم، دار القرآن الکریم، 1405ق.
52. سنن أبي داود، أبو داود السجستاني، سلیمان بن الأشعث (م. 275ق.)، دار إحیاء السنة النبویّة.
53. سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عیسی (م. 279ق.)، بیروت، دار الفکر، 1403ق.
54. سنن الدار قطني، الدارقطني، عليّ بن عمر (م. 385ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیّة، 1417ق.
ص: 228
55. سنن الدارمي، الدارمي، عبد الله بن الرحمن (م. 385ق.)، دمشق، مطبعة الاعتدال، 1349ق.
56. السنن الکبری، البیهقي، أحمد بن حسین (م. 458ق.)، بیروت، دار الفکر، 1416ق.
57. شرح إحقاق الحق، المرعشي النجفي، السّيد شهاب الدین (م. 1411ق.)، قم، مکتبة المرعشي النجفي، 1409ق.
58. شرح الإشارات والتنبیهات، الخواجة نصیر الدین الطوسي، محمد بن محمد (م. 672ق.)، قم، نشر البلاغة، 1383ش.
59. شرح الشمسیة، قطب الدین الرازي، محمد بن محمد (م. 776ق.)، إیران، الطبعة الحجریة، 1304ق.
60. شرح الکوکب المنیر، ابن النجّار، محمد بن أحمد (م. 972ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة.
61. شرح المطالع في المنطق، قطب الدین الرازي، محمد بن محمد (م. 776ق.)، قم، مکتبة المرعشي النجفي.
62. شرح المنظومة، السبزواري، هادي بن مهدي (م. 1289ق)، قم، مکتب العلّامة، 1369ش.
63. شرح صحیح مسلم، النووي، محیی الدین بن شرف (م. 676ق.)، بیروت، دار الکتاب العربي، 1407ق.
64. شرح فتح القدیر، الشوکاني، محمد بن عليّ (م.1250ق.).
65. شرح معاني الآثار، الطحاوي، أحمد بن محمد (م. 321ق.)، القاهرة.
66. الشفاء (المنطق)، ابن سینا، حسین بن عبد الله (م. 428ق.)، قم، مکتبة المرعشي النجفي، 1405ق.
ص: 229
67. شواهد التنزیل، الحاکم الحسکاني، عبید الله بن عبد الله (م. 506ق.)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1411ق.
68. صحیح ابن خزیمة، ابن خزیمة، محمد بن اسحاق (م. 311ق.)، المکتب الإسلامي، 1412ق.
69. صحیح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعیل (م. 256ق.)، بیروت، دار الفکر، 1401ق.
70. صحیح مسلم، المسلم النیسابوري، مسلم بن الحجّاج (م. 261ق.)، بیروت، دار الفکر.
71. الصحیفة السجادیة، الإمام عليّ بن الحسین(عَلَيْهَا السَّلاَمُ).
72. الصواعق المحرقة، الهیتمي، أحمد بن حجر (م. 974ق.).
73. الصواعق المرسلة علی الجهمیة والمعطّلة، ابن قیّم الجوزي، محمد بن أبي بکر (م. 691ق.).
74. الطبقات الکبری، ابن سعد، محمد بن سعد (م.230ق.)، بیروت، دار صادر.
75. العدّة فی اصول الفقه، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، قم، مطبعة تبریز، الطبعة الحجریة، 1314ق.
76. عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة، ابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن عليّ (م. 880ق.)، قم، مطبعة سیّد الشهداء(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، 1403ق.
77. الفتح الکبیر، السیوطي، جلال الدین (م. 911ق.).
78. فرائد الاصول، الأنصاري، مرتضی (م. 1281ق.)، تبریز، الطبعة الحجرية، 1314ق.
79. الفرق الإسلامیة، البشبیشي، محمود، القاهرة، المکتبة التجاریة الکبری، 1350ق.
ص: 230
80. الفصول الغرویة في الاُصول الفقهیة، الأصفهاني، محمد حسین بن عبد الرحیم (م. 1254ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث.
81. فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل (م. 241ق.)، بیروت، مؤسّسة الرسالة، 1403ق.
82. فوائد الاُصول، الخراساني، محمد کاظم (م. 1329ق.)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1407ق.
83. الفوائد الطوسیّة، الحرّ العاملي، محمد بن الحسن (م. 1104ق.).
84. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، بحرالعلوم، محمد بن محمد (م. 1225ق.)، قم، دار الذخائر، 1368ش.
85. الفهرست، ابن الندیم، محمد بن أبي یعقوب (م. 438ق.)، طهران، منشورات المروي، 1392ق.
86. قوانین الاُصول، ، القمي، المیرزا أبو القاسم بن الحسن (م. 1231ق.)، طهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة، الطبعة الحجریة، 1378ق.
87. الکافي، الکلیني، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363ش.
88. کامل الزیارات، ابن قولویه القمّي، جعفر بن محمد (م. 367ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1417ق.
89. کشف الأسرار، البخاري، عبد العزیز بن أحمد (م. 730ق.).
90. کفایة الأثر في النصّ علی الأئمّة الاثني عشر(علیهم السلام)، الخزاز القمّي، عليّ بن محمد (م. 400ق.)، قم، منشورات بیدار، 1401ق.
91. کفایة الاُصول، الخراساني، محمد کاظم (م. 1329ق.)، قم، مؤسّسة الن_شر الإسلامي، 1414ق.
ص: 231
92. الکفایة في علم الروایة، الخطیب البغدادي، أحمد بن علي (م. 463ق.)، المدینة المنوّرة، المکتبة العلمیة.
93. کنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، المتّقي الهندي، علاء الدین عليّ (م. 975ق.)، بیروت، مؤسّسة الرسالة، 1409ق.
94. اللمع في اُصول الفقه، الشیرازي، إبراهیم بن عليّ (م. 476ق.).
95. المباحث المشرقیة في علم الإلهیات والطبیعیات، الفخر الرازي، محمد بن عمر (م. 606ق.).
96. مبادی الوصول إلی علم الاُصول، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، 1404ق.
97. المبسوط في فقه الإمامیة، الطوسي، محمد بن الحسن (م.460ق.)، المکتبة المرتضویة، 1388ق.
98. المبسوط، السرخس_ي، محمد بن أحمد (م. 483ق.)، بیروت، دار المعرفة، 1406ق.
99. مجمع البحرین، الطریحي، فخر الدین (م.1085ق.)، طهران، المکتبة المرتضویة، 1375ش.
100. مجمع البیان في تفسیر القرآن، الطبرسي، فضل بن الحسن (م. 548ق.)، طهران، منشورات ناصر خسرو، 1373ش.
ص: 255
101. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهیثمي، عليّ بن أبي بکر (م. 807ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1408ق.
102. المجموع شرح المهذّب، النووي، محیي الدین بن شرف (م. 676ق.)، دار الفکر.
103. المحصول في علم اُصول الفقه، الفخر الرازي، محمد بن عمر (م. 606ق.)، بیروت، مؤسّسة الرسالة، 1412ق.
104. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، ابن حزم الاندل_سي، عليّ بن أحمد (م. 456ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة.
105. مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، میرزا حسین (م. 1320ق.)، بیروت، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1408ق.
106. المستدرك علی الصحیحین، الحاکم النیسابوري، محمد بن عبد الله (م. 405ق.)، بیروت، دار المعرفة.
107. المستصفی في علم الاُصول، الغزالي، محمد بن محمد (م. 550ق.)، قم، دار الذخائر، 1368ش.
108. مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل (م. 241ق.)، بیروت، دار صادر.
109. مسند الشافعي، الشافعي، محمد بن إدریس (م. 204ق.).
110. المسودة في اُصول الفقه، آل تیمیة، القاهرة، مطبعة المدني.
111. مشارق الشموس في شرح الدروس، الخوانساري، حسین بن محمد (م. 1099ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث.
112. مش_رق الشمسین وإکسیر السعادتین، البهائي، محمد بن حسین (م.1031ق.)، قم، مکتبة بصیرتي.
113. المصباح، الکفعمي، إبراهیم بن عليّ (م. 905ق.)، بیروت، مؤسّسة الأعلمي، 1418ق.
114. المصنّف في الأحادیث والآثار، ابن أبي شیبة الکوفي، عبد الله بن محمد (م. 235ق.)، بیروت، دار الفکر، 1409ق.
115. معارج الاُصول، المحقّق الحلّي، جعفر بن حسن (م. 676ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام)، 1403ق.
ص: 232
116. معالم الدین وملاذ المجتهدین، العاملي، حسن بن زین الدین (م. 1011ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي.
117. معانی الأخبار، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، قم، مؤسّسة النش_ر الإسلامي، 1361ق.
118. المعتبر في شرح المختصر، المحقّق الحلّي، جعفر بن حسن (م. 676ق.)، قم، مؤسّسة سیّد الشهداء(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، 1364ش.
119. المعتمد في اُصول الفقه، البصريّ، محمد بن عليّ (م. 436ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1403ق.
120. المعجم الصغیر، الطبراني، سیلمان بن أحمد (م. 360ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1404ق.
121. المعجم الکبیر، الطبراني، سلیمان بن أحمد (م.360ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1404ق.
122. المغني، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد (م. 620ق.)، بیروت، دار الکتاب العربي.
123. مفاتیح الجنان، المحدّث القمي، عبّاس (م. 1359ق.).
124. من لا یحضره الفقیه، الصدوق، محمد بن علي (م.381ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1404ق.
125. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، محمد بن عليّ (م. 588ق.)، النجف الأشرف، المکتبة الحیدریة، 1376ق.
126. منتقی الأخبار، الشوکاني، محمد بن عليّ (م. 1250ق.).
127. نقد المحصّل (تلخیص المحصّل)، الخواجة نصیر الدین الطوسي، محمد بن محمد (م. 672ق.).
ص: 233
128. نهایة الأفکار، العراقي، ضیاء الدین (م. 1361ق.)، قم، مؤسّسة ال_نشر الإسلامی، 1405ق.
129. نهایة المرام في علم الکلام، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.).
130. نیل الأوطار من أحادیث سیّد الأخیار، الشوکاني، محمد بن عليّ (م. 1250ق.)، بیروت، دار الجیل، 1973م.
131. وسائل الشیعة، الحرّ العاملي، محمد بن الحسن (م. 1104ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1414ق.
132. هدایة الأبرار إلی طریقة الأئمّة الأطهار(علیهم السلام)، الکرکي العاملي، حسین بن شهاب الدین (م. 1076ق.).
133. هدایة المسترشدین في شرح معالم الدین، الأصفهاني، محمد حسین بن عبد الرحیم (م. 1254ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث.
134. ینابیع المودّة لذوي القربی، القندوزي، سلیمان بن إبراهیم (م.1294ق.)، دار الاُسوة، 1416ق.
ص: 234
المقصد السادس: في المنجّز للحكم الشرعي شرعاً أو عقلاً. 7
الأمر الأوّل: المراد من «المكلَّف» في تقسيم الشيخ. 9
الأمر الثاني: مراتب الحكم 11
الأمر الثالث: تقسيم حالات المکلّف إلى القطع وغيره 15
المقام الأوّل: في القطع. 21
الأمر الأوّل: اُصولية مبحث القطع. 21
الأمر الثاني: معنى حجّية القطع. 24
الأمر الثالث: قيام الأمارات والاُصول مقام القطع الطريقي. 25
الأمر الرابع: في التجرّي.. 30
تحرير محلّ النزاع. 31
ردّ مقالة المحقّق الخراساني(قدس سره). 35
تفصيل صاحب الفصول(قدس سره). 37
الأمر الخامس: في العلم الإجمالي. 44
في المسألة أقوال. 44
جواز المخالفة مع جعل البدل. 48
الامتثال الإجمالي. 51
ص: 235
المقام الثاني: في الظنّ. 59
الأمر الأوّل: في محلّ النزاع. 59
الأمر الثاني: في المراد من الإمكان. 59
الأمر الثالث: في تأسيس الأصل. 61
الأمر الرابع: في استدلال ابن قبة للامتناع. 61
نقد القول بالمصلحة السلوكية. 69
تذنيبات.. 79
تتمّة. 87
الأمر الخامس: في تأسيس الأصل فيما لا يعلم حجّيته. 92
فصل: في حجّية ظاهر کلام الشارع. 95
الأمر الأوّل: في كون البحث من الاُصول. 95
الأمر الثاني: أقسام الألفاظ الموضوعة. 97
المراد من تبعيّة الدلالة للإرادة 100
الأمر الثالث: تحرير محلّ النزاع. 101
الاستدلال بسيرة العقلاء على حجّية الظواهر. 104
الاستدلال بحكم العقل. 105
حجّية الظواهر ليست ذاتية. 106
ردّ تفصيل القمّي(قدس سره). 110
ردّ مقالة الأخباريين. 112
أدلّة الأخباريّين. 113
الاستدلال بأخبار التحريف.. 119
ص: 236
اختلاف القراءات.. 122
فصل: في حجّية خبر الواحد 123
الخبر المتواتر وأقسامه. 123
خبر الواحد وأقسامه. 126
أدلّة المنكرين لحجّية خبر الواحد ونقدها 129
أدلة حجّية خبر الواحد 133
أمّا الكتاب.. 133
آية النبأ 133
نقد الاستدلال بآية النبأ 137
آية النفر. 147
تفاسير مختلفةٌ للآية. 147
نكتة. 152
كيفية الاستدلال بآية النفر. 153
إشكال الشيخ على الاستدلال بالآية. 154
فذلكة: في نقد وجوهٍ اُخرى للاستدلال بالآية. 162
الاستدلال بالسنّة على حجّية خبر الواحد 165
الاستدلال بالإجماع لحجّية خبر الواحد 168
تقريرات الشيخ للإجماع. 169
نقد کلام الشيخ الأنصاري.. 172
سبب إنكار المتکلّمين حجّية خبر الواحد 174
فصل: في الإجماع. 179
ص: 237
الاستدلال لحجّية الإجماع بالكتاب.. 180
الاستدلال لحجّية الإجماع بالسنّة. 182
نقد الاستدلال بالسنّة. 183
الإجماع عند الإمامية. 183
الإجماع المنقول. 186
فصل: في حجّية الشهرة 195
فصل: في دليل الانسداد 203
تقريرٌ آخر لدليل الانسداد 211
تنبيهات دليل الانسداد 214
التنبيه الثاني: عدم حجّية مطلق الظنّ. 218
التنبيه الثالث: نقاشٌ مع صاحب المعالم(قدس سره) والشيخ الأنصاري(قدس سره). 218
التنبيه الرابع: نتيجة دليل الانسداد 221
التنبيه الخامس: انحصار الطرق الظنّية في الخبر. 221
مصادر التحقیق. 223
ص: 238
الصورة

ص: 239
الصورة

ص: 240
الصورة

ص: 241
الصورة

ص: 242
الصورة

ص: 243
الصورة

ص: 244
الصورة

ص: 245
الصورة

ص: 246
الصورة

ص: 247
الصورة

ص: 248
سرشناسه:صافی گلپایگانی، لطف الله، 1298 -
Safi Gulpaygan, Lutfullah
عنوان و نام پديدآور:بیان الاصول/ تالیف لطف الله الصافی الگلپایگانی مدظله العالی.
مشخصات نشر:قم: مکتب تنظیم و نشر آثار آیت الله صافی گلپایگانی دام ظله، 1439 ق.= 1396 -
مشخصات ظاهر:3 ج.
شابک:دوره 978-600-7854-60-0 : ؛ 630000 ریال: ج.1 978-600-7854-57-0 : ؛ 630000 ریال: ج.2 978-600-7854-58-7 : ؛ ج.3 978-600-7854-59-4 :
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
يادداشت:عربی.
يادداشت:چاپ دوم.
يادداشت:ج.2 - 3(چاپ دوم: 1439 ق. = 1396)(فیپا).
يادداشت:کتاب حاضر تقریرات درس آیت الله سیدحسین بروجردی است.
یادداشت:کتابنامه.
یادداشت:نمایه.
موضوع:اصول فقه شیعه
موضوع:* Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction
شناسه افزوده:بروجردی، سیدحسین، 1253 - 1340.
رده بندی کنگره:BP159/8/ص26ب9 1396
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:4942697
اطلاعات رکورد کتابشناسی:فیپا
ص: 1
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 2
ص: 3
بیان الاُصول
تألیف المرجع الديني الأعلى آية اللّه العظمى الشيخ لطف اللّه الصافي الگلپايگاني مدّظلّه العالی
الجزء الثالث
ص: 4
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأوّل: في أصالة البراءة
الفصل الثاني: في أصالة التخيير
الفصل الثالث: في أصالة الاحتياط
الفصل الرابع: في الاستصحاب
ص: 5
ص: 6
قال في الكفاية في تعريف الاُصول العملية: «المقصد السابع: في الاُصول العمليّة، وهي الّتي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل... إلخ».((1))
ولا يخفى: أنّه حيث جعل تمايز العلوم بتمايز الأغراض الداعية إلى التدوين، وجعل الغرض من علم الاُصول معرفة القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، أو الّتي ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل، أشار هنا بأنّ كون مسائل الاُصول العمليّة من هذا العلم إنّما هو باعتبار كونها ممّا ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل. وقد أشبعنا الكلام في ما هو الملاك الاُصولية المسألة عند التعرّض لموضوع العلم (وهو الحجّة في الفقه) فلا نعيده في المقام، ومنه نعلم دخول هذه المسألة في مسائل هذا العلم، فراجع.
وقد أوردنا على ما أفاد بقوله: «فإنّ مثل قاعدة الطهارة... إلخ»((2)) بعدم كون قاعدة الطهارة من الأحكام الكلّية، لاختصاصها بالشبهات الموضوعية.
فأجاب(قدس سره): بأنّها وإن كانت كذلك إلّا أنّ الطهارة حيث تكون ممّا لا يعلم حقيقتها
ص: 7
إلّا من قبل الشرع تكون بهذا الاعتبار من الأحكام الكلّية.((1)) وكيف كان، فالبحث عنها ليس بمهمّ؛ لعدم جريانها في جميع الأبواب بخلاف الأربعة (أي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب).
وأفاد بقوله: «لو شكّ في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجّة، جاز شرعاً وعقلاً ترك الأوّل وفعل الثاني...»إلخ،((2)) أن لا حاجة إلى عقد مسائل متعدّدة بعد وحدة الملاك،((3)) كما فعل الشيخ(قدس سره)،((4)) فإنّه قد تكلّم أوّلاً في الشبهة التحريمية في ضمن مسائل أوّلها فيما لا نصّ فيه. وثانيتها: فيما إذا كان النصّ مجملاً. وثالثتها: في تعارض النصّين.
وثانياً: في الشبهة الوجوبية أيضاً في ضمن مسائل. مع اتّحاد ملاك البحث في الجميع، فإنّ إجمال النصّ وتعارض النصّين سواءٌ كانا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية ملحقان بفقدان النصّ. نعم، بناءً على التخيير في تعارض النصّين لا وجه لإلحاقه بما لا نصّ فيه، لمكان وجود الحجّة المعتبرة وهو أحد النصّين.
ويمكن أن يقال: إنّ في مسألة تعارض النصّين بناءً على التوقّف لا مجال لأصل البراءة إلّا في بعض موارده، فإنّه ليس معنى التوقّف سقوطهما عن الحجّية بالمرّة، بل معناه عدم كون کلّ واحد منهما حجّة في تعيين مؤدّاه في مقابل الآخر، وإلّا فلا ترفع اليد عن حجّيتهما في
ص: 8
نفي الثالث، فالرجوع إلى الأصل إنّما يجوز إذا كان موافقاً لأحد النصّين، كما لا يخفى.
وأمّا قوله: «جاز شرعاً وعقلاً»، فيحتمل أن يكون مراده أنّ فعل ما شكّ في حرمته وترك مشكوك الوجوب يجوز عقلاً، بمعنى عدم وقوع المكلّف في تبعة ترك التكليف وهو استحقاق العقوبة، لعدم كون الاحتمال موجباً لذلك. وشرعاً بمعنى عدم إيجاب الاحتياط الطريقي من قبل الشرع.
ويحتمل أن يكون المراد من الجواز الشرعي عدم كون التكليف فعلياً بحيث تعلّقت به الإرادة الفعلية، حتى يكون فعل محتمل الحرمة أو ترك محتمل الوجوب في صورة وجود التكليف مخالفةً للمولى وعصياناً له، بل هو باقٍ في مرتبة الاقتضاء والإنشاء. ومن الجواز العقلي عدم تنجّز التكليف بمعنى عدم كون مخالفته خروجاً عن رسم العبودية وطغياناً على المولى حتى يستحقّ بذلك العقاب.
وأمّا احتمال كون الجواز العقلي بمعنى عدم تبعةٍ للمكلّف في ارتكاب محتمل الحرمة وترك محتمل الوجوب، والجواز الشرعي بمعنى الحكم الظاهريّ المجعول في ظرف الشكّ، فهو خلاف التحقيق؛ فإنّ حكم العقل بعدم وقوع العبد في تبعة ترك التكليف متوقّف على حكمه بعدم تنجّز التكليف وجوازه بهذا المعنى، ومع عدم حكمه بعدم تنجّز التكليف لا مجال لحكمه بعدم وقوعه في تبعة تركه.
وأمّا الحكم الظاهري، فلا فائدة في جعله. مضافاً إلى أنّه لا دليل عليه، فإنَّ مثل حديث الحجب،((1)) والرفع((2)) إنّما يدلّ على رفع ما لا يعلمون، أو ما حجب الله علمه عن العباد، ولا دلالة لهما على الحكم الظاهريّ أصلاً؛ وما هو مثل: «كل شيء لك حلال...» إلخ فلا يجري إلّا في الشبهات الموضوعية دون الحكمية، هذا.
ص: 9
وممّا ذكرنا ظهر أنّ تحرير محلّ النزاع يمكن على أنحاء:
أحدها: أنّ الاحتمال هل يكون منجّزاً أو لا؟ بمعنى أنّ احتمال التكليف هل يكون موجباً لتنجّز التكليف المحتمل لو كان في البين، فيصحّ للمولى عقاب العبد لو لم يأت بمحتمل الوجوب أو أتى بمحتمل الحرمة ويعدّ خارجاً عن رسوم العبودية وطاغياً على المولى أو لا؟
ثانيها: أنّه هل أوجب الشارع الاحتياط الطريقي في موارد الشكّ في التكليف أو لا؟
والفرق بين هذا الوجه والوجه الأوّل: أنّ النزاع في الأوّل يكون كبروياً بأنّ الشكّ في التكليف هل يكون منجّزاً له أو لا؟ وفي الثاني يكون صغروياً وهو أنّ الشارع هل أوجب الاحتياط الطريقي في مورد احتمال التكليف أو لا؟ بعد اتّفاق الطرفين على تنجّز التكليف مع وجوب الاحتياط الطريقي.
ثالثها: أنّ التكليف هل يكون مع الشكّ فيه منجّزاً، إمّا لكون الاحتمال منجّزاً، أو لجعل الشارع الاحتياط الطريقي أو لا؟
والوجه الأوّل هو محلّ نزاع القدماء في أصالة البراءة ومورد لجريانها عندهم، وقد يعبّر عنها في کلماتهم بحكم العقل أو استصحاب حال العقل.
ومرادهم من استصحاب حال العقل: أنّ العقل قبل بعث النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بالشرع مستقلٌّ بعدم كون الاحتمال منجّزاً وعدم تنجّز التكليف به، فبعده أيضاً حاله حال ما قبل الشرع، فيستصحب حاله قبل الشرع إلى ما بعده.
وأمّا الوجه الثاني، فقد حدث الاختلاف فيه بين المتأخّرين من الأخباريّين في الشبهة التحريمية، لما زعموا من دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية دون غيرها.
ص: 10
ولا يخفى عليك: أنّه بناءً على الوجه الأوّل - في تحرير محلّ النزاع - لا مجال للاستدلال بالأخبار، والدليل عليه منحصرٌ في حكم العقل واستقلاله له بقبح مؤاخذة المولى عبده بالمخالفة المترتّبة على عدم الاعتناء باحتمال التكليف.
وأمّا ما في ألسنتهم في مقام الاستدلال على البراءة من قبح العقاب بلا بيان، فهو عين المدّعى، إلّا أن يراد منه استقلال العقل بذلك.
وبناءً على الوجه الثاني لا مجال للاستدلال بالدليل العقلي، بل الدليل على عدم إيجاب الاحتياط ليس إلّا الأخبار.
وأمّا على الوجه الثالث فيجب اختصاص الدليل العقلي لإثبات عدم كون الاحتمال منجّزاً للتكليف، والأدلّة النقلية لإثبات عدم وجوب الاحتياط. فما استقرّ عليه مشي المتأخّرين كالشيخ والمحقّق الاُستاذ في الكفاية من ذكر الأدلّة الأربعة دليلاً على البراءة على حدّ سواء؛ ليس في محلّه، كما لا يخفى.
ثم إنّه لا يخفى عليك: أنّ ما ذكره المحقّق الاُستاذ في عبارته المذكورة الّتي صدرت تحريراً لمحلّ النزاع في أصل البراءة وهو قوله: «ولم تنهض حجّة عليه جاز شرعاً وعقلاً... إلخ».
لا يستقيم بحسب الظاهر، فإنّ الحجّة عبارة عمّا ينجّز التكليف ويوجب استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي، وعليه فمعنى هذه العبارة أنّه لو شكّ في وجوب شيء أو حرمته ولم ينجّز ذلك التكليف المحتمل ولم يقم عليه ما يوجب استحقاق العقاب على مخالفته، لم يكن ذلك التكليف منجّزاً وليس العبد في مخالفته مستحقّاً للعقاب. وهذا ليس أمراً يتنازع فيه، لضرورته وعدم تطرّق احتمال الخلاف فيه؛ فإنّ التكليف إذا لم يكن منجّزاً لم يكن منجّزاً.
فعلى هذا، لابدّ أن يكون غرضه من هذه العبارة: أنّه لو شكّ في تكليف إلزاميّ ولم
ص: 11
يقم على أحد طرفيه دليل، جاز عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، ولا يكون مجرّد الاحتمال منجّزاً للتكليف الواقعي.
لا يقال: إنّ مجرّد الاحتمال والشكّ لا يمكن أن يكون منجّزاً للتكليف، ولا أظنّ أحداً يلتزم به حتى يقع ذلك محلّا للنزاع.
فإنّه يقال: إنّ هذا وإن كان يوجد في کلمات بعضهم ولكن لا أصل له، لإمكان كون الاحتمال منجّزاً، بل هو واقعٌ في بعض الموارد كاحتمال صدق مدّعي النبوّة، فإنّه منجّزٌ وموجبٌ لاستحقاق العقاب على عدم الاعتناء بالتحقيق والتفحّص وتحصيل المعرفة لو اتّفق كون من يدّعي النبوّة صادقاً (دون من لا يحتمل ذلك أصلاً كالمسلم المعتقد بخاتمية دين الإسلام وأنّ محمّداً(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) خاتم النبيّين). ومثل احتمال وجود التكاليف في الشريعة، فإنّه بنفسه ملزمٌ للفحص ومنجّزٌ للتكاليف الواقعية. نعم، ليس في الشكّ جهة كشف عن الواقع كالظنّ فلا يصحّ جعله حجّة بملاحظة جهة كشفه كالظن فإنّه ترجيح بلا مرجح.
وإذا قد عرفت ذلك کلّه، فاعلم: أنّ الكلام يقع تارةً في أصل البراءة على الوجه الأوّل - الّذي ذكر في تحرير محلّ النزاع - فنقول: إنّ الوجدان أعظم شاهدٍ على أنّ العبد إذا احتمل توجّه تكليفٍ إليه من جانب المولى وتفحّص عنه ولم يجده لم يستحقّ في مخالفة هذا التكليف - بعد الفحص عنه وعدم الظفر به - العقاب، وليس للمولى توبيخه لمخالفته هذه، ولا يعدّ عند العقلاء خارجاً عن رسوم العبودية وطاغياً على المولى، فليس هذا الاحتمال منجّزاً لذلك التكليف بعد الفحص وعدم الظفر به.
ولا فرق في ذلك بين كون عدم ظفره بهذا التكليف لعدم بيان المولى رأساً، أو لعدم وصول البيان إلى العبد. فإنّ العقل لا يرى تفاوتاً بينهما في حكمه بعدم تنجّز هذا التكليف، فكما أنّ التكليف لا يصير منجّزاً مع احتمال نسيان المولى بيانه ولو علم عدم
ص: 12
صدور بيانٍ منه، كذلك لا يصير منجّزاً مع عدم العثور على بيانه مع الفحص وإن احتمل صدوره منه واختفاؤه عنّا لبعض الجهات الموجبة للاختفاء. فليس احتمال صدور البيان مع الفحص وعدم الظفر به إلّا كاحتمال النسيان في صورة العلم بعدم صدور البيان.
وأمّا الاستدلال على هذا بقبح العقاب بلا بيان فليس إلّا مصادرة بالمطلوب ومِن جعل الدليل عين المدّعى، لرجوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضاً إلى حكم العقل بعدم استحقاق العقاب بمجرّد احتمال التكليف بعد الفحص وعدم الظفر.
وربما يستدلّ لعدم كون الاحتمال منجّزاً للتكليف بما قد مرّ تحقيقه منّا، وملخّصه: أنّ فعلية الحكم لا تتصوّر إلّا في ظرف العلم به؛ فإنّ الحكم عبارةٌ عن إنشاء الخطاب متسبّباً به لانبعاث العبد؛ وروحه وحقيقته عبارة عن إرادة انبعاثه أو انزجاره في ظرف علمه بذلك الخطاب ووصوله إليه، فإنّه لا يمكن إرادة انبعاثه عنه أو انزجاره به مطلقاً، حتى في صورة الجهل به، لعدم إمكان انبعاثه أو انزجاره كذلك، ولذا لو كان المولى مهتمّاً بحفظ تكاليفه وأراد فعلية أحكامه وانبعاث عبده نحوها مطلقاً، يجب عليه جعل حكم آخر طريقي كإيجاب العمل بالأمارة أو الأخذ بالحالة السابقة أو غيرهما.
لا يقال: انبعاث العبد نحو ما کلّفه به ليس منحصراً بصورة العلم به بل يمكن انبعاثه في ظرف احتمال التكليف.
فإنّه يقال: إنّ الانبعاث في ظرف احتمال التكليف ليس مسبّباً عن حكم المولى وتكليفه، فإنّه ليس معلولاً لوجود التكليف، بل ربما يحتمل التكليف وينبعث العبد من هذا الاحتمال ولا يكون تكليفٌ في البين أصلاً، بخلاف صورة وصوله إلى العبد فإنّ الانبعاث في ظرف وصوله مسبّبٌ عن وصول التكليف وهو مسبّبٌ عن نفس هذا التكليف.
ص: 13
فعلى هذا، لا تصير خطابات المولى فعليةً إلّا في ظرف العلم بها ووصولها إلى العبد، لعدم إرادة انبعاثه منه إلّا في هذا الظرف. وتستحيل فعلية الحكم وإرادة انبعاث العبد من الخطاب في ظرف الجهل، لاستحالة انبعاثه عنه في صورة الجهل به وإن كان يمكن انبعاثه عن احتمال التكليف.
فظهر: أنّ في صورة الاحتمال لا يكون التكليف فعلياً، لعدم إرادة المولى انبعاث العبد عن خطابه في هذا الظرف، لعدم إمكان انبعاثه كذلك. وإذا لم يكن التكليف فعلياً لا يكون منجّزاً بحيث يستحقّ العقاب على تركه، هذا.
ولكن لا حاجة إلى هذا البيان بعدما ذكرنا من استقلال العقل بعدم تنجّز التكليف بمجرّد الاحتمال، وكون ذلك من البديهيات الّتي لا يحتاج إثباتها إلى توسيط شيءٍ وتجشّم استدلالٍ.
نعم، هنا اُمور((1)) قيل بكون کلّ واحد منها وارداً على هذه القاعدة العقلية ومنجّزاً للتكليف المحتمل وموجباً للعلم باستحقاق العقاب في ظرف الاحتمال، بعضها بل کلّها - غير واحدٍ منها - تجري في الشبهة التحريمية، وواحدٌ منها تجري فيها وفي الشبهة الوجوبية.
وتقريره على نحو يعمّ الشبهة الوجوبية أيضاً: أنّ احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة ملازمٌ لاحتمال الضرر، أي العقاب على ترك الواجب المحتمل وفعل محتمل الحرمة، والعقل حاكمٌ بوجوب دفع الضرر المحتمل وقبح ترك محتمل الوجوب وفعل محتمل الحرمه، لاحتمال الضرر في ترك الأوّل وفعل الثاني، فبمقتضى قاعدة الملازمة (وهي: کلّ ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته) نستكشف حكم الشرع
ص: 14
بحرمة مخالفة التكليف المحتمل. فعلى هذا ولو سلّم عدم كون نفس احتمال التكليف منجّزاً له، لكن يجب الحكم بتنجّزه بمقتضى هذه القاعدة.
وفيه: أنّه بعد استقلال العقل بعدم تنجّز التكليف بمجرد الاحتمال لا نحتمل ضرراً في ترك التكليف المحتمل، ولا ملازمة بين احتمال التكليف واحتمال الضرر والعقاب، وهذا واضحٌ لا سترة عليه.
وأمّا تقريره على نحو يختصّ بالشبهة التحريمية، فبيانه: أنّ في ترك ما يحتمل حرمته احتمال الوقوع في الضرر، ولا نعني به العقاب والمؤاخذة - الّتي ملاك صحّتها تحقّق عنوان المخالفة والطغيان والخروج عن رسوم العبودية - بل المراد منه احتمال الوقوع في المفسدة الموجبة لتحريم الفعل، وهي ضررٌ قطعاً ويجب دفعه ويحرم ارتكابه عقلاً، فيكون شرعاً كذلك لقاعدة الملازمة.
لا يقال: إنّ ما هو المسلّم وجود المصلحة في التكليف وهي كما يمكن أن تكون إيصالاً إلى مصلحة الفعل المأمور به وحفظاً عن مفسدة الفعل المنهيّ عنه يمكن أن تكون راجعةً إلى جهة اُخرى. وهذا مضافاً إلى أنّ المفاسد المترتّبة على الأفعال المحرّمة - الّتي توجب تحريمها من قبل الشرع - ليست کلّها راجعة إلى الفاعل بل كثيراً ما تكون راجعةً إلى غيره، كالمفاسد الاجتماعية الّتي تترتّب على بعض المحرّمات، ولا يجب عقلاً دفع الضرر عن الغير.
فإنّه يقال: إنّ ذلك لا يدفع احتمال الضرر المذكور، فإنّ من المحتمل أن تكون مصلحة تحريم هذا الفعل - الّذي احتملت حرمته - حفظ المکلّف عن وقوعه في مفسدته، ومن المحتمل أن تكون المفسدة المترتّبة على الفعل راجعةً إلى فاعله دون غيره.
والّذي ينبغي أن يقال في الجواب: إنّ دفع الضرر المحتمل غير الاُخروي لا يكون حسناً ولا تركه قبيحاً مطلقاً حتى في صورة قيام الاحتمالات غير العقلائية، بل ربما يكون الاعتناء به قبيحاً في هذه الصورة.
ص: 15
وأمّا إن كان من الاحتمالات العقلائية، فلا يكون عدم الاعتناء به قبيحاً بحيث يكون موجباً للمؤاخذة واستحقاق التوبيخ والذمّ واللوم، كالظلم والعدوان، ومورداً لاشمئزاز العقل وانزجاره، ولا يكون الاعتناء به حسناً بحيث يكون فاعله مستحقّاً للمدح والثواب، كالعدل وغيره، ولا يحكم على من جعل نفسه في معرض الضرر بالعقاب والعذاب وإن كان يعدّ عند العرف بأنّه هو المقدم على هذا الضرر والباعث لوروده مع كونه مدركاً له ومختاراً في حفظ نفسه ومفطوراً على الفرار عنه.((1))
هذا، وربما يتمسّك لوجوب دفع الضرر المحتمل بحكم الشارع.
وهو في غاية الفساد، لعدم وجوبه شرعاً. بل لم يثبت وجوب دفع الضرر المقطوع به شرعاً مطلقاً وبالنسبة إلى جميع الموارد، فضلاً عن دفع الضرر المحتمل. ولو سلّم وجوب دفع المقطوع منه مطلقاً، فصورة احتماله تكون من باب الشبهة الموضوعية، فلا يجب فيه الاحتياط.
إنّ الأصل في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع هو الحظر، وحيث إنّ مدرك ذهاب القائلين بالحظر إلى هذا القول حكم العقل بقبح التصرّف فيما هو ملكٌ للغير وتحت سلطانه بدون إذنه، فيستكشف من قاعدة الملازمة حكم الشرع على تحريمه
ص: 16
أيضاً. فالانتفاع من الأعيان الخارجية لا يجوز إلّا بإذن الله تعالى، فإنّ کلّ ما في دار التحقّق والوجود ملكٌ له وهو مالكه، فالانتفاع من الأعيان الخارجية تصرّفٌ في ملكه وسلطانه، وهو بلا إذنٍ منه قبيحٌ عقلاً وظلمٌ، فيكون حراماً شرعاً للقاعدة المذكورة. وبعد ذلك لا مجال للقول بعدم استحقاق العقاب وعدم تنجّز التكليف المحتمل وإباحة ارتكاب محتمل الحرمة عقلاً وشرعاً، فإنّه إنّما يتمّ إذا لم يكن في البين منجّزٌ للتكليف غير احتماله. فلا منافاة بين القول بعدم تنجّز التكليف بمجرّد الاحتمال وبين الحكم بتنجّز محتمل الحرمة لهذه القاعدة.
وفيه: أنّه وإن وقع الاختلاف بين العلماء في أنّ الأصل في الأفعال قبل الشرع هل هو الحظر أو الإباحة (وغرضهم من قبل الشرع ليس قبل شرع الإسلام أو شريعةٍ اُخرى، بل غرضهم قبل أن يصدر من الشارع بالنسبة إليه تكليفٌ وحكمٌ من الأحكام الخمسة)، وقد ذهبت معتزلة بغداد، وابن أبي هريرة من الشافعية، وجماعة من قدماء الإمامية إلى الحظر، ولكن ليس لهم على ذلك حجّة قاطعة فإنّهم استدلّوا - كما ذكر - بأنّ التصرّف في الأعيان الخارجية تصرّفٌ في ملكه سبحانه وهو قبيحٌ وحرامٌ عقلاً وشرعاً. ومن يرى منهم تعميم ذلك الحظر بالنسبة إلى جميع أفعال المکلّف يقول: إنّ العبد أيضاً ملكٌ لخالقه وما اُوتي من نعمة البصر واليد واللسان وغيرها من الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة ملكٌ له فلا يحسن صرفها بدون إذنه ويستقبح العقل التصرّف فيه، وهكذا حال الشرع لقاعدة الملازمة.
ولكن لنا أن ننكر أصل حكم العقل بالحظر بالملاك المذكور بالنسبة إلى العبيد ومولاهم الحقيقي، فإنّ التصرّف في ملك الغير إنّما يحكم عليه بالقبح لو كان منطبقاً مع عنوان من العناوين المقبحة العقلية كالظلم، وإلّا فليس کلّ تصرّفٍ في ملك الغير قبيحاً وحراماً عقلياً. نعم، إذا كان ذلك التصرّف خلاف غرض المولى ومزاحماً مع سلطانه ومالكيته يصير قبيحاً بملاك وقوعه تحت عنوان الظلم.
ص: 17
وأمّا إذا لم يكن كذلك، كتصرّفات العباد غير المنافية لمالكية مالك السماوات والأرضين وسلطانه فلا يكون قبيحاً وظلماً. ويؤيّد ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ الله الَّتي أَخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالطيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾((1)) وغيرها من الآيات، فإنّ هذه الآية ليست في مقام إنكار تحريم زينة الله الّتي أخرجها لعباده من جانب الشرع، أو إنشاء حكم الحلّية وجواز الانتفاع عمّا أخرجه لعباده. بل هي في مقام بيان عدم وجود مناطٍ ودليلٍ من العقل والشرع على ذلك، وتوبيخ من يحرم على نفسه ما أخرجه لعباده من غير دليلٍ عقليٍ ولا شرعيٍ، وأنّ الأفعال والانتفاع ممّا أخرجه لعباده بحسب الطبع الأوّلي ليس حراماً، ولا يكون المنتفع منه مع عدم صدور حكم حرمته من الشرع مستوجباً للتقبيح عند العقل. وإلّا فلو كان ذلك عند العقل قبيحاً لصحّ الجواب عن الاستفهام المذكور في الآية بأنّ العقل حاكمٌ بقبح التصرّف في ملك الله تعالى من غير إذنٍ منه.
استدلّ الأخباريّون بالآيات والروايات على وجوب الاحتياط الطريقي في الشبهات التحريمية الحكمية، ولو تمّ الاستدلال بها يكون منجّزاً للتكليف المحتمل التحريمي وإن لم يكن مجرّد احتماله منجّزاً له. وحيث إنّ الأخباري ذهب إلى وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية دون الموضوعية والشبهات الوجوبية، فلابدّ لمن يراجع ما استدلّ عليه من الكتاب والسنّة من ملاحظة مقدار دلالة هذه الأدلّة وأنّها على تقدير تماميّتها هل تختصّ بالشبهات التحريمية الحكمية أو تعمّها وغيرها من الشبهات الوجوبية والموضوعية.
ص: 18
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّهم استدلّوا على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية بالآيات القرآنية والروايات.
أمّا الآيات الّتي استدلّ بها على الاحتياط فطائفتان:
إحداهما: ما دلّت على النهي عن القول بغير علمٍ، كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.((1)) وقوله عزَّ من قائل: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.((2)) وغيرهما من الآيات الكثيرة الّتي ربما تبلغ ستّة عشر آيةً. بتقريب: أنّ الحكم بالجواز والترخيص في ما يحتمل حرمته قولٌ بغير علمٍ.
وجوابه يظهر ممّا أسلفناه،((3)) فإنّا لا نقول في محتمل الحرمة بالجواز الشرعي، ولا ندّعي ترخيص الشارع ارتكاب محتمل الحرمة حتى يقال بأنّكم تقولون على الله ما لا تعلمون، بل نحن ندّعي أنّ العقل مستقلّ بأنّ العبد لو احتمل التكليف بعد بذل جهده في سبيل الفحص عن الحكم ولم يطّلع على ما يدلّ عليه من الأدّلة، فليس مستحقّاً للعذاب والعقاب لو ارتكب ما يحتمل حرمته أو ترك ما يحتمل وجوبه. وليس معنى ذلك ترخيص الشارع ارتكاب محتمل الحرمة والحكم بالجواز الشرعي.
هذا مضافاً إلى أنّ هذا الدليل ناهضٌ على الأخباري، فإنّ القول بوجوب الاحتياط، والتفكيك بين الشبهة الوجوبية والتحريمية وبين الموضوعية والحكمية، قولٌ بغير علمٍ.
ص: 19
ثانيتهما: ما تدلّ بظاهرها على وجوب الاحتياط والتورّع والاتقاء، كقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا الله َ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.((1)) وقوله سبحانه: ﴿وَاتَّقُوا الله َ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾.((2)) وقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي الله ِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾.((3)) وقوله عزّ شأنه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.((4)) وقوله تعالى: ﴿فَإنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ﴾.((5))
والجواب: أمّا عن الآيات الثلاثة الاُول، فبمنع كون التقوى والجهاد في الله حقّ جهاده إتيان العبادات الاختراعية وتحريم المحلّلات وأخذ طريق التضييق وإدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في الدين ولو كان بعنوان الاحتياط، بل حقيقتهما عبارة عن كمال الاهتمام والمراقبة في فعل الواجبات وترك المحرّمات وحضور العبد لذلك وقيامه بوظيفة العبودية. ولا دخالة لفعل محتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة في ذلك. وليس ترك الأوّل وفعل الثاني مخالفاً للتورّع والتقوى، وإلّا يجب أن يكون العالم بجميع الأحكام الممتثل لها غير حائز لصفة التقوى.
وأيضاً لا ريب في أنّه لا يستفاد من هذه الآيات إيجاباتٌ مستقلّةٌ، كسائر الأوامر والنواهي الراجعة إلى الموضوعات المختلفة، وإلّا يلزم أن يكون الآتي بالصلاة آتياً بواجبين، أحدهما: ما وجب بالأمر بنفس الصلاة، وثانيهما: ما تعلّق بعنوان الاتّقاء.
فالمستفاد منها: أنّ المتكلّم يكون في مقام تنبيه العباد وتذكيرهم بأنّ المکلّف يجب أن يتحرّز ويجتنب عن مخالفة التكاليف الإلهية، ويبذل غاية جهده في فعل الواجبات وترك المحرّمات بأن لا يترك من الواجبات شيئاً ولا يعمل بواحدٍ من المحرّمات.
ص: 20
والغرض من هذه التنبيهات إيقاظ الغافلين من نومة الغفلة، وسوق من لا يعظّم أمر أحكام الله إلى تعظيمها والجري على وفقها. فلا يستفاد من هذه العبارات أزيد ممّا يكون الواعظ في مقام بيانه من بيان ما يكون باعثاً لرغبة الناس إلى الطاعات وانزجارهم عن السيّئات.
ولا أظنّك أن تحتمل بأنّ هذه الآيات الكثيرة والروايات الواردة عن الأئمّة المعصومين(علیهم السلام) بكثرتها، مثل ما روي عن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - في المواعظ والخطب المشتملة على الأمر بالتقوى، تكون في مقام إيجاب التقوى، لأنّ کلّها - كما تنادي بذلك المراجعة إلى كتب الروايات والمواعظ الصادرة عنهم(علیهم السلام) - في مقام الإرشاد والترغيب والتحريض، وإيجاد الدواعي في المکلّفين لفعل الواجبات وترك المحرمات.
هذا، ولو احتمل أحدٌ خلاف ذلك، وحمل هذه الآيات على كونها في مقام إنشاء إيجاب التقوى - كسائر الخطابات الواردة في غير هذا المورد - فلا فرق حينئذٍ في ذلك - أي وجوب الاتّقاء - بين الشبهات التحريمية والوجوبية، وبين الشبهة الحكمية والموضوعية، ولا وجه للتفصيل بينهما كما زعمه الأخباري.
وأمّا الجواب عن الاستدلال بالآية الرابعة: فبأنّ المراد من التهلكة إن كان الهلكة الاُخروية فنقطع بعدمها. وإن كان المراد الهلكة الدنيوية، فالمحرّم هو الإلقاء في الهلكة المعلومة، وأمّا ما لم يعلم وجود التهلكة فيه فالشبهة بالنسبة إليه موضوعية.
وأمّا الاستدلال بالآية الخامسة ففيه أوّلاً: أنّ من الممكن أن يكون المراد ممّا تنازعوا فيه الشبهة الموضوعية، فإنّه يجب فيه الرجوع إلى القضاة المنصوبين من جانب الله والرسول، لا قضاة الجور ومن تولّى أمر القضاء من جانب غير المنصوب من قبل الله تعالى وهو الرسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ).
ص: 21
وثانياً: لو سلّمنا أنّ المراد منه هو الشبهة في الحكم، فلا يستفاد منه إلّا وجوب التسليم لأمر الله تعالى وأمر الرسول. ولا منافاة في ذلك مع القول بالبراءة وعدم استحقاق العقاب على فعل محتمل الحرمة بعد الفحص عمّا صدر عن الله والرسول واليأس عن الظفر.
هذا مضافاً إلى عدم الوجه في التفصيل بين الشبهة التحريمية الحكمية وغيرها.
هذا تمام الكلام في الآيات الّتي استدلّ بها الأخباريّون.
وأمّا الروايات: فقد جمعها بعضهم كصاحب الوسائل - عليه الرحمة - في كتاب القضاء،((1)) وهي وإن كانت تبلغ - قبل إسقاط ما تكرّر منها وما ليس مرتبطاً بما نحن فيه - 68 حديثاً، إلّا أنّ جملة منها غير مرتبطة بالمقام. وجملةً منها في مقام الرّد على العامّة ومن يأخذ بالقياس والاستحسان ويستقلّ في استنباط الأحكام، ولا يرى للأئمّة المعصومين(علیهم السلام) ما لهم من المقام في بيان أحكام الله ولا يرجع إليهم، ويريد الهدى من تلقاء نفسه. وجملة منها راجعة إلى الوقوف عند الشبهات الّتي يظهرها أهل الأهواء والبدع ومن ينتحل الإسلام - ممّا يكون شبيهاً بالدليل والبرهان وليس منه - مثل ما يرى كثيراً في کلما ت هؤلاء من الصدر الأوّل إلى زماننا هذا.
وثلاثةً منها - وهي: ما رواه عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم».((2))
ص: 22
وما رواه عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «من عمل بما علم كفي ما لم يعلم».((1))
وما رواه عن محمد بن عليّ بن الحسين قال الصادق(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهيٌ».((2)) - تدلّ على خلاف مطلوب الأخباري.
وأجاب عن هذه الروايات بأجوبةٍ غير كافيةٍ، منها: حمل هذه الأخبار على الشبهات الوجوبية.((3)) وجملةً منها راجعة إلى النهي عن القول بغير علم.
وجملةً اُخرى واردة في الشبهات البدوية قبل الفحص.
وبعضاً منها واردة في الشبهات الموضوعية، كما رواه عن الصدوق(رحمه الله) من أنّ أمير المؤمنين(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) خطب، فقال: «إنّ الله حدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلّفوها، رحمةً من الله لكم فاقبلوها». ثم قال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «حلالٌ بيّنٌ وحرامٌ بيّن وشبهاتٌ بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها یوشك أن يدخلها».((4))
وقد جعل صاحب الوسائل ذيلها روايةً مستقلّةً وجعلها الرواية 27 من هذا الباب.((5))
وبعضاً منها ليس خالياً عن الإبهام والإجمال، كروايةٍ رواها سلام بن المستنير عن أبي جعفر الباقر(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: «قال جدي رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): أيّها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة، ألا وقد بيّنهما الله عزّ وجلّ في الكتاب، وبيّنتُهما لكم في سنّتي وسيرتي، وبينهما شبهاتٌ من الشيطان وبدعٌ بعدي، من تركها صلح له أمر دينه
ص: 23
وصلحت له مروّته وعرضه، ومن تلبّس بها وقع فيها واتّبعها كان كمن رعى غنمه قرب الحمى...» الحديث.((1))
وبالجملة: فما يمكن أن يدّعى ارتباطه بالمقام ودلالته على ما ذهب إليه الأخباريون هي الروايات الّتي التقطها الشيخ(رحمه الله) من هذه الروايات وجعلها طوائف:((2))
إحداها: ما يكون مفادها مفاد الآيات، وتدلّ على حرمة القول والعمل بغير علم.((3)) وقد مرّ الجواب((4)) عنها عند ذكر الجواب عن استدلالهم بالآيات.
ثانيتها: الأخبار الدالّة على التوقّف. وقد ذكر منها اثني عشر حديثاً.
ثالثتها: أخبار الاحتياط. وذكر منها سبعة أحاديث.
رابعتها: أخبار التثليث.
ولا يخفى عليك: أنّ الطائفة الرابعة ترجع إلى الطائفة الثانية، وليست طائفةً مستقلّةً؛ فإنّ اختلاف التعابير لا يوجب اختلاف المضمون وتكثير الأقسام.
فعلى هذا، تجب الملاحظة والتأمّل في طائفتين من الروايات، إحداهما: أخبار الاحتياط. وثانيتهما: أخبار التوقّف.
أمّا أخبار الاحتياط، فأكثرها مراسيل لا يعتمد عليها، مثل: ما روى في الوسائل عن خطّ الشهيد(قدس سره) في حديثٍ طويل عن عنوان البصري عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد(علیهما السلام) يقول فيه: «سل العلماء ما جهلت، وإيّاك أن تسألهم تعنّتاً وتجربةً، وإيّاك أن تعمل
ص: 24
برأيك شيئاً، وخذ بالاحتياط في جميع اُمورك ما تجد إليه سبيلاً، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبةً للناس».((1))
وما أرسله الشهيد في الذكرى أيضاً وحكي عن الفريقين، قال النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».((2))
وما أرسله أيضاً عن الصادق(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لك أن تنظر الحزم، وتأخذ بالحائطة لدينك».((3))
وما أرسله الشهيد(قدس سره) أيضاً عنهم(علیهم السلام): «ليس بناكبٍ عن الصراط، من سلك سبيل الاحتياط».((4))
هذا مضافاً إلى عدم دلالتها على وجوب الاحتياط.
أمّا رواية عنوان البصري، فإنّه كان رجلاً متقشّفاً من تلامذة مالك بن أنس، وقد صرف مدّة من عمره في المدينة لأخذ الفقه عن مالك، ولم يكن يعرف الإمام الصادق(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بالإمامة. ولكنّه أراد أن يزوره ليستفيد منه، فلم يأذن له، فدخل المسجد وصلّى ودعا الله أن يرقّق قلب جعفر بن محمد الصادق(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) عليه، وبعد أن حصل الإذن تشرّف بزيارته وسأله عن مسائل فأجابه عنها، وقال له الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «سل العلماء ما جهلت...»، الحديث.
وهذا كما ترى لا يدلّ على وجوب الاحتياط في محتمل الحرمة أو الوجوب، بل کلام صدر عن الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) موعظةً لهذا الشخص الّذي لا يرى للإمام امتيازاً عن الناس، ولا يعرفه بالمقام الّذي أقامه الله فيه. ومن الواضح أنّ بهذه الكلمات والبيانات
ص: 25
يجب أن يوعظ وينذر مثل هذا الشخص الّذي يدّعي العلم والفقه ولا يحترز عن الفتوى ولا يرجع إلى أئمّة أهل البيت(علیهم السلام).
وأمّا ما روى من قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإنّما يدلّ على الإرشاد إلى حسن الاحتياط واستحبابه.
وأمّا الروايتان الأخيرتان، فليس فيهما دلالة على وجوب الاحتياط بمعنى وجوب ترك محتمل الحرمة وفعل محتمل الوجوب. غير أنّ ذكر لفظ الحائط والاحتياط فيهما صار سبباً لتوهّم ذلك؛ فإنّ المراد من اللفظين هو الاحتفاظ والاهتمام بأمر الدين.
وكذا الرواية المنقولة عن أمالي المفيد الثاني عن الرضا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «أنّ أمير المؤمنين قال لكميل بن زياد: أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت».((1)) فإنّه ليس المراد من هذا الاحتياط المأمور به إلّا القيام بأمر الدين من العمل بما أوجب فيه وترك ما حرم. وأمّا رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو على کلّ واحدٍ منهما جزاءٌ؟ قال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا، بل عليهما أن يجزي کلّ واحدٍ منهما الصيد». قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ما عليه، فقال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».((2))
ففيها أوّلاً: أنّها لا تدلّ إلّا على وجوب الاحتياط في الفتوى والتحرّز والاجتناب عنه قبل السؤال والفحص.
وثانياً: لو أغمضنا عن ذلك فلا تدلّ إلّا على وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين أو غير الارتباطيين، لو لم نقل بكونهما كذلك في المقام.
ص: 26
وأمّا رواية عبد الله بن وضّاح وهي: أنّه كتب إلى العبد الصالح(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) يسأله عن وقت المغرب والإفطار؟ فكتب إليه: «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك».((1))
فظاهرة في الشبهة الموضوعية الوجوبية، والانتظار - مع الشكّ في تحقّق المغرب - للصلاة هو مقتضى الاستصحاب. والمراد بالأخذ بالحائطة لدينك ليس الاحتياط المذكور في کلامنا، بل هو الأخذ بما يحفظ به دينه وهو الانتظار عملاً بالاستصحاب.
وممّا ذكرنا ظهر: أنّ دعوى استفاضة الروايات الدالّة على الاحتياط لا يصدر إلّا عمّن ليس له اطلاعٌ بالروايات.
وأمّا أخبار التوقّف، فبعضها لا دلالة له على وجوب الاحتياط في العمل، كرواية حمزة بن طيّار أنّه عرض على أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعاً منها قال له: «كفّ واسكت». ثم قال أبو عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلّا الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد، ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحقّ، قال الله تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.((2))
فإنّ الظاهر منها أنّ الموضع الّذي بلغ منها كان متضمّناً لبعض المطالب المعضلة من الاُصول أو الفروع الّتي لا ينبغي لأمثال حمزة بن طيّار إظهار الرأي فيها، ويجب أن يعرف حقيقتها وما هو الحقّ فيها من قبل المعصوم العالم بحقائق مثل هذه الاُمور من قبل الله تعالى.
وبعضها على وجوب التوقّف عند الفتوى وحرمة القول بغير علم أدلّ وأظهر، مثل: رواية جابر عن أبي جعفر(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في وصيّةٍ له لأصحابه قال: «إذا اشتبه الأمر عليكم
ص: 27
فقفوا عنده، وردّوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا، فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوه إلى غيره...»، الحديث.((1))
ورواية زرارة عنه(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: سألت أبا جعفر(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ما حجّة الله على العباد؟ قال: «أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون».((2))
ورواية الميثمي - الّذي عبّر عنه الشيخ الأنصاري بالمسمعي - عن الرضا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في حديث اختلاف الأحاديث قال:«وما لم تجدوه في شيءٍ من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا».((3))
نعم، في عدّةٍ منها الأمر بالتوقّف عند الشبهة معلّلاً بأنّ الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة؛ أو ذكر هذه الجملة مستقلّةً وابتداءً كما في مقبولة عمر بن حنظلة؛((4)) ورواية الزهري؛((5))ورواية السكوني؛((6))ورواية مسعدة بن زياد؛((7))ورواية أبي شيبة؛((8))ورواية جميل بن دراج؛((9))ورواية عبد الأعلى.((10))
ولكن يمكن أن يقال - مضافاً إلى أنّ اشتمال بعض هذه الروايات على عبارات مثل:
ص: 28
«وتركك حديثاً لم تروه خيرٌ من روايتك حديثاً لم تحصه»((1)) ربما يصير سبباً لإجمال هذه العبارة -: إنّ المراد بالشبهة ما يحتمل فيه الهلكة، لا مطلق الشبهة ولو لم يحتمل فيها الهلكة.
وإن أغمضنا عن ذلك، وقلنا بأنّ المراد بالشبهة خصوص الشبهة التحريمية، وأنّ الهلاكة هي الهلكة الاُخروية، كما يريده الأخباري. فليس في هذه الأخبار ما يمكن أن يدّعى دلالته على خصوص الشبهة التحريمية الحكمية دونها والموضوعية، كما يظهر للمتأمّل في الأخبار.
اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ النبويّ المذكور في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة((2)) - مع قطع
ص: 29
النظر عن احتفافه بكلام الإمام، وما يقتضي سياق أصل الرواية، واستشهاد الإمام بالنبويّ المذكور - يدلّ على المطلوب.
ولا يرد على الاستدلال به ما يرد على الاستدلال بأصل المقبولة من شمولها للشبهات الحكمية والموضوعية بقسميهما، بل تشمل غير التكاليف من الاُمور الوضعية. ومن اختصاصها بالشبهات الّتي يكون الوقوع في الهلكة بالنسبة إليها مقطوعاً كالإفتاء بغير علمٍ؛ فالوقوف عند الشبهة والامتناع من الإفتاء خيرٌ من الاقتحام في الهلكة وهو الإفتاء بغير علم.
والحاصل: أنّه يمكن أن يقال بصحّة استناد الأخباريّ إلى هذا النبويّ في خصوص الشبهة التحريمية. والقول بعدم دخل صدر المقبولة وذيلها في ما يستفاد من مضمونه. أو بكون هذا النبويّ روايةً مستقلّةً رواها عمر بن حنظلة هنا عن الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ).
وقريبٌ منه في هذه الدلالة رواية جميل بن صالح عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) قال: قال رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): - في کلام طويلٍ - «الاُمور ثلاثةٌ: أمرٌ تبيّن لك رشده فاتّبعه، وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه، وأمرٌ اختلف فيه فردّه إلى الله عزّ وجلّ».((1))
ومرسلة الصدوق قال: وخطب أمير المؤمنين(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، فقال: «إنّ الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلّفوها، رحمةً من الله لكم فاقبلوها. ثم قال: حلالٌ بيّنٌ، وحرامٌ بيّنٌ، وشبهاتٌ بين ذلك،
ص: 30
فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها یوشك أن يدخلها».((1))
فعلى هذا، أوضح الروايات دلالة على ما يريده الأخباري هذا النبويّ الّذي لم يتعرّض لذكره بعض من صار في مقام الجواب عن الأخبار الّتي استدلّ بها الأخباري كالمحقّق الاُستاذ صاحب الكفاية، ومن تعرّض لذكره لم يأت في مقام الجواب بما كان حاسماً للإشكال، فيجب علينا أن نبيّن وجه الاستدلال به أوّلاً والجواب عنه ثانياً إن شاء الله تعالى، فنقول:
أمّا تقريب الاستدلال به: فغاية ما يمكن أن يقال هو: أنّ المستفاد من هذا النبويّ أنّ لنا حلالاً بيّناً من حيث الحكم، وأفعالاً کلّيةً حليتها مبيّنةٌ، وأفعالاً کلّيةً حرمتها مبيّنةٌ، وشبهاتٍ بين ذلك، أي أفعالٌ کلّيةٌ غير مبيّنةٍ من حيث الحكم، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات الواقعية الّتي تكون في هذه الشبهات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات الواقعية الّتي تكون في مورد هذه الشبهات وهلك من حيث لا يعلم، أي يقع فيما يقع فيه مرتكب الحرام من الخروج عن زيّ العبودية ورسوم الرقّية واستحقاق العذاب والعقاب.
وليس المراد من الشبهات جميعها، بل جنسها ولو كانت شبهةً واحدةً، كما أنّ المراد بالمحرّمات أيضاً ليس کلّها بل جنسها، فلو أخذ بشبهةٍ واحدةٍ يقع في الحرام، أي يصير في معرض الوقوع في الحرام وجعل نفسه في مورد ارتكاب الحرام.
وليس المراد من الوقوع الإشراف على الحرام حتى يكون استعمال الوقوع فيه على سبيل مجاز المشارفة كما ذكره الشيخ، وتحتاج تمامية الاستدلال إلى الكبرى الكلّية
ص: 31
الحاكمة على أنّ الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم حرامٌ. فإن قلت: إنّ الرواية ظاهرةٌ في الإرشاد إلى أنّ ارتكاب الشبهة موجبٌ للوقوع في الهلكة الّتي تكون فيها مع قطع النظر عن هذا البيان، وهي تارةً تكون اُخروية واُخرى دنيوية، كالشبهات غير المقرونة بالعلم الإجمالي وقبل الفحص.
قلت: نعم، صدرها إلى قوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «فمن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات» ظاهر في الإرشاد، ولكن قوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «وهلك من حيث لا يعلم» يدلّ على وجود الهلاكة والعذاب في مورد الشبهة إذا صادف ارتكابها الحرام الواقعي.
فإن قلت: إنّ هذا - لو تمّ - يدلّ على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية مطلقاً موضوعيةً كانت أم حكميةً، لظهور النبويّ في حصر الحلال والحرام فيما هو بيّنٌ وما ليس كذلك.
قلت: لم يذكر في الرواية ما هو مقسمٌ لهذه الأقسام حتى يستفاد منه أنّها من الشبهة الحكمية أو الموضوعية، وليس بينهما جامعٌ.
فإن قلت: ما الما نع من أن يكون المراد من النبويّ والمستفاد منه أنّ لنا حلالاً بيّناً بحسب الخارج وحراما بيّناً بحسب الخارج وشبهاتٍ بين ذلك أيضاً في الموضوع، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات أي الوقوع في الحرام البيّن الخارجي، ومن لم يجتنب منها يقع في الحرام البيّن الخارجي ويجتري على ارتكابه بخلاف من ترك الشبهات؛ فإنّ جرأته على ارتكاب الحرام المعلوم في الخارج ليس بهذه المثابة.
ويؤيّد ذلك ما رواه الصدوق عن أمير المؤمنين(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في خطبته، إلّا أنّه ينافي قوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «وهلك من حيث لا يعلم».
اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّه بعد فرض عدم ذكر مقسمٍ للشبهات الحكمية والموضوعية في الرواية وإمكان حملها على الشبهات الموضوعية، فلم لا نقول بأنّ المراد منها: أنّ لنا
ص: 32
حلالاً بيّناً بحسب الخارج وحراماً كذلك وشبهاتٍ بين ذلك؟ فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات الواقعية الّتي تكون فيما بين المشتبهات، ومن ارتكب هذه الشبهات، أي المصاديق المشكوك كونها تحت بعض العناوين المحرّمة، يقع في المحرّمات الواقعية الّتي تكون فيما بينها. ولا منافاة لهذا الاحتمال مع قوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «وهلك من حيث لا يعلم» وكيف كان: فلا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر.
قلت: لا مانع من هذا الاحتمال في نفسه، إلّا أنّ للأخباري أن يقول: الظاهر هو الاحتمال الأوّل.
هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالنبويّ.
والتحقيق في الجواب أن يقال أوّلاً: إنّ الحرام الفعلي ما تعلّق به زجر المولى وإرادته الحتمية، ولا يتحقّق ذلك إلّا إذا كان للعبد إليه طريقٌ ووصل نهي المولى إليه. وأمّا ما ليس له طريقٌ إليه أصلاً ولم يصل إليه حتى بعد الفحص فليس حراماً فعلياً، ولا يشمله عنوان محتمل الحرمة حقيقةً، بل هو من الحلال البيّن، للعلم بعدم تعلّق زجرٍ فعليٍّ من المولى إليه وعدم تعلّق إرادته الحتمية بتركه، ومع ذلك كيف يحتمل حرمته ويدخل تحت الشبهات الّتي تكون بين الحلال والحرام البيّنين. فالمراد بالمشتبهات ما يحتمل في مورده فعلية زجر المولى وإرادته الحتمية المتعلّقة بتركه، وهو لا يكون إلّا في الشبهات البدوية قبل الفحص. وأمّا بعد الفحص وعدم الظفر بالطريق فيحصل القطع بعدم فعلية زجر المولى وعدم تعلّق إرادته الحتمية بتركه. فالمشتبه بالحرام لا يكون إلّا ما يحتمل في مورده فعلية زجر المولى، وهو لا يتحقّق إلّا في الشبهات البدوية الّتي يحتمل وجود الطريق إلى الحكم الشرعيّ الّذي يكون في موردها. فعلى هذا، لا مانع من القول بظهور الهلاكة المذكورة في قوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «وهلك من حيث لا يعلم» في الهلاكة الاُخروية، لكنّ المراد بها الهلاكة الّتي تكون للمشتبه مع قطع النظر عن هذه
ص: 33
العبارة وهي لا تكون إلّا في الشبهات البدوية. وكون هذه الرواية في مقام إيجاب الاحتياط وجعل الطريق إلى الأحكام الواقعية الّتي ليس إليها طريقٌ مع قطع النظر عن إيجاب الاحتياط الطريقي، خلاف الظاهر؛ فإنّ ظاهرها كونها في مقام الإرشاد إلى ما يحكم العقل به وهو لزوم الاجتناب عن الهلاكة الّتي تكون في المشتبهات مع صرف النظر عن هذه العبارة.
وثانياً: لو تمّ الاستدلال بهذه الرواية يجب القول بالاحتياط حتى في الشبهات الوجوبية؛ فإنّ هذه الرواية النبويّة بهذه العبارة ليست مرويّةً إلّا في ضمن مقبولة عمر بن حنظلة وهي باعتبار موردها - وهو اشتباه الحكم الوضعي الّذي يكون منشأً لانتزاع حكمٍ تحريميٍ ومنشأً لانتزاع حكمٍ وجوبيٍ - تشمل الشبهات الوجوبية أيضاً.
وثالثاً: لو قلنا بدلالة هذا النبويّ على وجوب الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية من جهة كون ارتكابها معرضاً لوقوع المرتكب في الحرام المشتبه، لكنّه تعارضه رواياتٌ كثيرةٌ دالّةٌ على عدم مانعٍ من ارتكاب الشبهة من جهة الوقوع في الحرام المحتمل الّذي يكون في مورده.
فغاية الأمر يستحبّ الاجتناب عنها لحصول ملكة التحفّظ والقدرة على ترك المحرّمات. ولأنّ فعل المشتبهات ربما يصير باعثاً لوقوع مرتكبها في المحرّمات المعلومة، فإنّ المعاصي حمى الله ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه كما روي عن أمير المؤمنين(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في ضمن خطبته: «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها».((1))
ورابعاً: لا ريب في أنّ وجوب الاحتياط لو كان مجعولاً في الشريعة لنقل إلينا
ص: 34
ولعرفه جميع المسلمين؛ لشدّة الابتلاء به وعموم البلوى، واستقرّت عليه سيرتهم الكاشفة عن وجود نصٍّ أو نصوصٍ معتبرةٍ في المسألة، مع أنّه لم يوجد من هذا رسمٌ ولا أثرٌ لا في الكتب ولا في عمل المسلمين، ولم يوجد خبرٌ يدلّ عليه، إلّا هذا الخبر الّذي أشكل في دلالته، بل لم يذكر هذا الموضوع في کلما ت السابقين، وإنّما حدث هذا التوهّم في أوائل القرن الحادي عشر عند تداول شرب التنباك، وذهاب بعض الأخباريين إلى حرمته فصار سبباً لإحداث القول بوجوب الاحتياط في مطلق الشبهات التحريمية الحكمية، مع أنّ شبهة حرمة شرب التتن ليست من الشبهات الحكمية بل شبهةٌ موضوعيةٌ، فإنّ شرب التنباك لم يكن في زمن النبيّ والأئمّة(علیهم السلام) متداولاً حتى يرد فيه بخصوصه حكمٌ ويكون الشكّ فيه داخلاً في الشكّ في الحكم، بل لو شكّ فيه فلا يكون منشأ الشكّ إلّا كونه واقعاً تحت بعض العناوين المحرّمة مثل: «الخبائث»((1)) أم لا، فيكون بهذا الاعتبار من الشبهات الموضوعية، ولا ارتباط له بالشبهات الحكمية. هذا تمام الكلام في استدلالهم بالأخبار.
من الاُمور الّتي قيل بكون کلّ واحدٍ منها وارداً على حكم العقل بعدم تنجّز التكليف المحتمل بعد الفحص وعدم الظفر به بمجرّد الاحتمال، هو: العلم الإجمالي بوجود محرّماتٍ كثيرةٍ في الشريعة، ومقتضاه وجوب الاحتياط في الموارد المشتبهة.
وفيه: مضافاً إلى كون ذلك منقوضاً بالشبهات الوجوبية، لعدم وجهٍ لاختصاص العلم الإجمالي بالتكاليف التحريمية، أنّنا ننكر هذا العلم الإجماليّ الوسيع المتعلّق
ص: 35
بوجود التكاليف الوجوبية والتحريمية فيما بين مؤدّيات الطرق والأمارات، وفيما ليس بين مؤدّيات الطرق ممّا ليس إليه طريقٌ؛ فإنّ من كان عالماً ببعث النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وتبليغه أحكام الله تعالى يعلم إجمالاً بوجود تكاليف في الشريعة بحيث لو تفحّص عنها من طرقها لوصل إليها. ولا يرى مجالاً لاحتمال وجودها في الطرق المتعارفة المتداولة، لاستلزام ذلك نقض الغرض ولزوم اختراع الشرع طريقةً اُخرى في تبليغ مقاصده ومراداته غير ما استقرّ عليه بناء العقلاء وسيرتهم. وكيف يصحّ جعل حكمٍ وتكليفٍ مع عدم وجود طريقٍ إليه؟ ولو فرضنا احتمال ذلك فهو احتمالٌ بدويٌّ يزول بعد المراجعة إلى الطرق والأخبار. وعلى فرض بقائه ليس منجّزاً للتكليف.
ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا بوجود هذا العلم الإجمالي الوسيع، فنقول: إنّ بعد الرجوع إلى الطرق والأمارات المثبتة للتكاليف نعلم إجمالاً بوجود هذه التكاليف بين مؤدّيات الطرق والأمارات بالمقدار المعلوم بالإجمال أوّلاً، ومعه ينحلّ العلم الإجمالي الكبير إلى هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعيّةٍ فيما بأيدينا من الطرق بالمقدار المعلوم بالإجمال أوّلاً وعدم وجود غير ما بأيدينا من مؤدّيات الطرق والأمارات ممّا ليس إليه طريقٌ.
ولا نقول بانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بعد الرجوع إلى الأمارات والظفر بالطرق المثبتة للتكاليف بالمقدار المعلوم بالإجمال، حتى يقال بعدم الانحلال على القول بالسببية والموضوعية في باب الأمارات مطلقاً، وأمّا على القول بالطريقية أو جعل المنجّزية والحجّية فينحلّ لو كان ما نحن فيه من أقسام الصورة الاُولى من صور العلم الإجمالي - الّتي سيأتي ذكرها في التنبيه الآتي - وأمّا في سائر الصور فانحلاله محلّ للمناقشة والإشكال كما يأتي.
ص: 36
تنبيه: في تنقيح معنى الانحلال((1))
إعلم: أنّ العلم الإجمالي متقوّمٌ من علمٍ متعلّق بالمعلوم بالإجمال كالنجس المردّد في كونه إناء عمرو أو إناء زيدٍ مثلاً، وترديد هذا المعلوم بين شيئين أو أشياء، وإذا انحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي فلا يبقى ذلك الترديد ولا يعقل بقاؤه؛ فإنّ فرض بقائه مساوقٌ لفرض عدم انحلاله.
لا يقال: فما معنى قولهم: إنّ العلم الإجمالي ينحلّ إلى العلم التفصيلي والشكّ البدويّ؟
فإنّه يقال: هذا الشكّ البدويّ الّذي يبقى بعد الانحلال ليس الشكّ الّذي به يتقوّم العلم الإجمالي، فإنّه يزول بمجرّد الانحلال، بل هذا الشكّ زائدٌ على هذا الشكّ. كما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين بالبول واحتملنا نجاسة الآخر منهما بالدم، ثم علمنا تفصيلاً ما تنجّس منهما بالبول؛ فإنّ العلم الإجمالي وإن انحلّ وزال الشكّ الّذي هو مقوّمٌ له إلّا أنّ الاحتمال والشكّ الّذي كان لنا في نجاسة الآخر بالدم باقٍ على حاله، وليس هذا الشكّ البدوي أثر الانحلال بل هو الشكّ الّذي كان موجوداً مع العلم الإجمالي غير التردّد الّذي كان أحد مقوّميه. ولذا لو لم يكن مع العلم الإجمالي هذا الشكّ، كما إذا علم غصبيّة أحد الإناءين ولم يحتمل غصبيّة الآخر منهما ثم علم تفصيلاً غصبيّة أحدهما، ينحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي من غير أن يكون في البين شكّ بدويٌ. فتارةً: ينحلّ العلم الإجمالي إلى التفصيلي من دون أن يكون معه شكٌّ بدويٌّ، وتارة: يكون معه ذلك. فالمراد من الشكّ البدويّ الشكّ غير المقارن للعلم الاجمالي.
وليعلم: أنّ العلم الإجمالي لا ينحلّ إلى التفصيلي إلّا في موردٍ كان تقدّم العلم
ص: 37
التفصيلي مانعاً عن حدوث العلم الإجمالي حتى يكون حدوثه متأخّراً عنه مانعاً عن بقائه، فإذا علمنا بغصبيّة أحد الشيئين ثم علمنا تفصيلاً غصبيّة أحدهما المعيّن ينحل العلم الإجمالي. وأمّا إذا علمنا بغصبيّة أحد الكبشين ثم علمنا تفصيلاً بكون واحدٍ منهما جلّالاً لا ينحلّ علمنا الإجمالي. وهذا کلّه واضحٌ والتعرّض له إنّما هو لاحتمال خفائه عن بعضٍ. وبعد ذلك نقول:
إنّ العلم الإجمالي تارةً: يتعلّق بغصبيّة إناء زيدٍ من الإناءين المعلوم كون واحد منهما ملكاً لعمرو والآخر لزيدٍ، ويتعلّق العلم التفصيلي بأنّ هذا الواحد المعيّن هو إناء زيدٍ، ففي هذه الصورة ينحلّ العلم الإجمالي بغصبية ما هو منهما إناء زيد بالعلم التفصيلي بما هو إناء زيد، وأما الشكّ البدويّ بالنسبة إلى غصبيّة إناء عمرو فهو باقٍ على حاله إ
ذا احتملنا غصبيّته مع العلم بغصبية إناء في البين إلى العلم التفصيلي والشكّ البدويّ بالنسبة إلى إناء عمرو لو احتمل غصبيته.
وتارةً: يتعلّق بغصبيّة أحدهما، ويتعلّق العلم التفصيلي بكون أحدهما المعيّن - كإناء زيدٍ - غصباً، وفي هذه الصورة أيضاً ينحلّ العلم الإجمالي وإن كان انحلاله في الصورة الاُولى أوضح.
وثالثةً: يتعلّق بعنوانٍ ويتعلّق التفصيلي بعنوان آخر، كما إذا تعلّق العلم الإجمالي بكون خمسة شياه من قطيع غنمٍ مغصوبةً وعلم تفصيلاً بكون خمسةٍ منها شربت من لبن الخنزيرة حتى اشتدّ عظمها، فهل ينحلّ العلم الإجمالي في هذه الصورة أيضاً أو لا؟
يمكن أن يقال بأنّ ما يجب أن يكون العبد بصدده هو الاجتناب عن الحرام ومبغوض المولى وتحصيل الأمن من عقوبته من غير فرقٍ بين أن يكون مندرجاً تحت عنوان الغصب أو غيره، فبعد هذا العلم التفصيلي يعلم تفصيلاً بوجوب اجتنابه عن هذا الحرام المعيّن ويشكّ في حرمة غيره، وهذا معنى انحلال العلم الإجمالي إلى التفصيلي.
ص: 38
ولكنّ الأقوى عدم الانحلال في هذه الصورة إذ لا تمانع بين العلمين، لقيام الحجّة على تكليفين أحدهما: وجوب الاجتناب عن الغنم المغصوبة المردّدة في البين مثلاً، والآخر: وجوب الاجتناب عن الغنم الجلّالة مثلاً، ولا انحلال هنا لبقاء العلم الإجمالي بغصبية أحد الغنمين مع العلم التفصيلي بكون أحدهما المعيّن جلّالاً. فكلٌّ من العلمين مؤثّرٌ في تنجّز خطابٍ خاصٍّ وحجّةٍ على تكليف المولى ولا تمانع بينهما، فلو أكل من لحم الغنم المعيّن المعلوم كونه جلّالاً واتّفق كونه هو المغصوب ارتكب حرامين ووقع في مخالفة تكليفين. ولو اتّفق عدم كونه غصباً - ولكن بسبب ارتكابه الطرف الآخر وقع في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال - يكون عاصياً أيضاً.
وأمّا أنّ همّ العقل هو الاجتناب عن الحرام ومبغوض المولى ولا فرق في ذلك بين كون حرمته من جهة الغصب أو جهة اُخرى.
ففيه: أنّ العصيان والطغيان لا يتحقّق إلّا بارتكاب ما هو الحرام بالحمل الشائع كالمغصوب والجلّال، وهو الّذي يتعلّق التكليف بالاجتناب عنه ويكون منهيّاً عنه، لا مفهوم الحرام وما هو الحرام بالحمل الأوّلي، وبعد هذا نقول: إنّ العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن المغصوب المردّد بينهما موجبٌ لتنجّزه وحجّةٌ عليه، والعلم التفصيلي بوجوب الاجتناب عن أحدهما المعيّن المعنون بكونه جلّالاً موجب لتنجّز التكليف بوجوب الاجتناب عن هذا الجلّال، ولا تمانع بينهما أصلاً.
ورابعةً: يتعلّق العلم الإجمالي بما هو أعمّ ممّا هو متعلّق العلم التفصيلي، كما لو تعلّق العلم الإجمالي بحرمة أحد الكبشين وتعلّق العلم التفصيلي بكون أحدهما المعيّن غصباً. أو بالعكس بأن يكون متعلّق العلم التفصيلي أعمّ ومتعلّق العلم الإجمالي أخصّ، كما لو تعلّق العلم الإجمالي بغصبيّة أحد الغنمين وتعلّق العلم التفصيلي بحرمة أحدهما المعيّن. وفي انحلاله وعدمه في هذه الصورة وجهان: من عدم تمانعٍ ومطاردةٍ بين العلمين،
ص: 39
واستقلال العقل بتنجّز التكليف المعلوم بالإجمال بسبب العلم الإجمالي، وعدم موجبٍ لانحلال ذلك العلم؛ ومن انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، وعدم موجبٍ لوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر بعد الانطباق، فيتعيّن الاجتناب عن المعلوم بالتفصيل ويصير الطرف الآخر مشكوكاً.
وربما يقال - بالنظر إلى الوجه المذكور في عدم انحلال العلم الإجمالي في هذه الصورة - بعدم انحلاله في الصورة الثانية أيضاً. فما يكون الانحلال بالنسبة إليه مسلّماً هو الصورة الاُولى. ولا فرق فيما ذكرنا بين تقدّم العلم الإجمالي على التفصيلي وعدمه؛ وبين تقدّم حدوث المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل وعدمه.
هذا کلّه إذا كانت الحجّة على التكليف علماً وقطعاً. وأمّا إذا كانت الحجّة غيره من المنجّزات، فعلى القول في باب الأمارات بالموضوعية والسببية، لا معنى للانحلال أصلاً في جميع الصور حتى في الصورة الاُولى. وأمّا على القول بالطريقية ووجوب الجري على وفق الطريق، وهكذا على القول بجعل المنجّزية والحجّية ينحلّ في الصورة الاُولى حكماً؛ فإنّ معنى قيام الأمارة على كون هذا الإناء المعيّن إناء زيد كون ذلك إناءه دون الآخر، ومقتضى ذلك سقوط العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن الإناء النجس المردّد بين كونه إناء زيدٍ وإناء عمرو، عن رتبة تنجيز التكليف إذا كان في الطرف الآخر. وأمّا في سائر الصور، فعلى القول بالانحلال الحقيقي فيها ينحلّ حكماً أيضاً، وعلى القول بعدم الانحلال فلا انحلال هنا حكماً أيضاً.
ثم إنّه قد ظهر ممّا ذكر عدم وجود منجّزٍ للتكليف المحتمل بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل، وأنّ احتمال التكليف لا يكون موجباً لتنجّزه بحيث يعدّ عدم الاعتناء به ومخالفته خروجاً عن رسوم العبودية وزيّ الرقّية حتى يترتّب عليه استحقاق العقاب.
ص: 40
فالحقّ في المسألة هو البراءة وعدم استحقاق العبد للعقاب على مخالفة التكليف المحتمل. وقد استدلّوا عليها مع ذلك بالآيات والأخبار.
أمّا الآيات، فمنها قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾.((1))
وتقريب الاستدلال بها: أنّ المستفاد من الآية عدم العذاب في ارتكاب ما يكون مبغوضاً لله تعالى - فعلاً كان أو تركاً - قبل بعث الرسل، وأنّ هذا من سنن الله تعالى. وليس لبعث الرسول دخلٌ في ذلك إلّا لأجل أنّ تبيين الأحكام والتكاليف بتوسّط الرسول، وكونه وسيلة لتبيين الأحكام وتبليغها وإيصالها إلى المکلّفين. فيكون المراد عدم التعذيب على ارتكاب المبغوض قبل البيان. ونفي التعذيب وإن كان يمكن أن يكون نفياً لفعليته لا نفياً لاستحقاقه، إلّا أنّ مناسبة المقام تقتضي كونه نفياً للاستحقاق؛ فإنّه في مقام أنّ الله تعالى لا يفعل ذلك ولا يعذّب عبده قبل البيان وليس من شأنه هذه الأفعال. هذا مضافاً إلى أنّه لو قلنا بكونه نفياً لفعلية العذاب قبل البيان يلزم كون فعليته ثابتة بعد البيان مع أنّ فعليته بعده غير معلومةٍ.((2))
واستشكل على الاستدلال بهذه الآية الكريمة بإشكالات من قبيل: أنّها ظاهرة في نفي الفعلية لا نفي الاستحقاق وهو أخصّ منه، ونفي الأخصّ أعمّ من نفي الأعمّ. ومن قبيل: دخالة عدم بعث الرسول في نفي العذاب، لا مطلق عدم البيان.
ص: 41
ومنها قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا﴾.((1))
والاستدلال بهذة الآية متوقّف على بعض التكلّفات؛ فإنّ الاستثناء مفرّغ لعدم ذكر المستثنى منه في الكلام، فلو كان المراد بالموصول التكليف يجب أن يكون المستثنى منه أيضاً التكليف، حتى يكون المراد منه: لا يكلّف الله نفساً تكليفاً إلّا تكليفاً آتاها، أي أعلمها، وهذا کلّه خلاف الظاهر؛ فإنّ ظاهرها كون المراد بالموصول المال لا التكليف. وعلى فرض كون المراد به التكليف يستلزم الدور، فإنّ التكليف بناءً على هذا متوقّفٌ على الإعلام ووصوله إلى المکلّف، ووصوله موقوفٌ على التكليف.
واُجيب عن هذا الدور بأنّ المراد من التكليف الأوّل التكليف الفعلي، أي لا يكلّف الله نفساً تكليفاً فعلياً إلّا تكليفاً وصل إليه.
وعلى کلّ حال التمسّك بمثل هذه الآية للمطلوب لا يخلو عن تكلّف.
ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إذْ هَدَيهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَ-هُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾.((2))
والظاهر أنّ هذه الآية على ما استدلّ له أدلّ من غيرها؛ فإنّ مفادها أنّ الله تعالى لا يضلّ قوماً، أي لا يحرمهم عن توفيقه والإعانات الباطنية الّتي تسوق الإنسان إلى الكمالات، بعد هدايتهم ببعث النبيّ وبيان المعارف والعقائد بسبب ارتكابهم مبغوضاً حتى يبينّ لهم ما يتّقون، أي حتى يبيّن لهم أحكامه وما يجب فعله عليهم وما يحرم ارتكابه، وليس من شأنه الإضلال الّذي هو قسمٌ من العقوبة على اكتساب السيّئات والخروج عن رسم العبودية بعد هدايتهم ببعث النبيّ، إلّا أن يبيّن لهم ما يتّقون وارتكابهم خلاف ما اُمروا به وما نهوا عنه واستحقاقهم للإضلال والحرمان عن
ص: 42
الإعانات الباطنية؛ فإنّه على هذا لا يكون إضلالهم وعقوبتهم على خلاف ما يكون الله تعالى أهلاً له.
ومنها قوله تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّ-نَةٍ وَإِنَّ الله لَسَميعٌ عَلِيمٌ﴾.((1))
ولكن الاستدلال بها على ما نحن بصدده لا يتمّ على جميع الاحتمالات المتطرّقة فيها؛ فإنّ المراد بالهلكة والحياة إمّا يكون الروحانية منهما أو الجسمانية، أو يكون المراد من إحداهما الروحانية ومن الاُخرى الجسمانية، وعلى جميع هذه التقادير فإمّا أن يكون قوله تعالى: ﴿عَنْ بَيِّن-َةٍ﴾ متعلّقاً بقوله تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ﴾ و﴿يَحْيَى﴾ أو متعلّقاً ب- «من هلك» و«مَنْ حَيَّ».
فلو كان متعلّقاً بالأوّل يكون معناه على احتمال أن يكون المراد بالهلاك والحياة الروحانية منهما أنّ ما فعل الله تعالى ممّا هو مذكور في صدر الآية وهو قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنْتُمْ بالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْ-مِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللُه أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً﴾((2)) إنّما فعل لإراءة الحقّ وإظهار الواقع؛ فإنّ غلبة فئةٍ قليلةٍ على فئةٍ كثيرةٍ خصوصاً مع ما كان عليه المشركون من القوّة والشوكة والسلاح يعدّ من الاُمور الخارقة للعادة، وفعل الله کلّ ذلك حتى يهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنةٍ، كما هو الشأن في إظهار غيره من خوارق العادات. وعلى احتمال أن يكون المراد منهما الهلكة والحياة الجسمانيّتين يكون المفاد: أنّ ما أنعم الله على النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) والمسلمين في غزوة بدر من نصرتهم على المشركين مع قلّة عدد المسلمين إنّما يكون لأجل أن يهلك من هلك من المشركين عن بيّنةٍ ويحيى من حيّ من المسلمين عن بيّنةٍ.
ص: 43
وأمّا لو كان قوله: «عن بيّنةٍ» متعلقاً ب «من هلك» وب- «مَنْ حَيَّ» يكون المعنى أنّ الله غلّب المسلمين على المشركين ليهلك الهلكة الجسمانية - على احتمال - من هلك عن بينةٍ وهم أعداء النبيّ والمسلمين؛ فإنّهم قد رأوا من الرسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) المعجزات الباهرات ومع ذلك لم يؤمنوا، فيكون هلاكهم عن بيّنة، ويحيى بالحياة الجسمانية من حيّ بالحياة الروحانية عن بيّنةٍ وهم المسلمون، أو ليهلك بالهلاك الروحاني - على الاحتمال الآخر - من هلك عن بيّنةٍ، ويحيى بالحياة الروحانية من حيّ عن بيّنة لمزيد بصيرته وثقته بصدق النبي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ).
هذا، ولكن لا يتمّ الاستدلال بواحدٍ من هذه الاحتمالات على البراءة؛ فإنّه ليست في الآية دلالة على أنّ الهلكة لا تتحقّق في جميع الموارد إلّا عن بيّنة، فيمكن أن لا تكون الهلكة الراجعة إلى الفروع كالهلكة الراجعة إلى الاُمور الاعتقادية الّتي لا تتحقق إلّا عن بيّنةٍ. هذا بعض الكلام في الآيات.
استدلّوا للبراءة بروايات لا معارضة لها مع ما استدلّ به الأخباري من الأخبار على وجوب الاحتياط - لو سلّم تماميته - مثل قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»؛((1)) وقوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «الناس في سعة ما لم يعلموا»،((2)) فلا نطيل الكلام بذكرها. نعم، ينبغي إرسال الكلام في حديث الرفع لما فيه من الفائدة.
ص: 44
إعلم: أنّ الكلام في هذا الحديث الشريف يقع في طيّ اُمور:
إعلم: أنّه قد روى شيخنا الكليني ثقة الإسلام - رضوان الله تعالى عليه - عن الحسين بن محمد،((1)) عن محمد بن أحمد النهدي،((2)) رفعه عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: قال رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «وضع عن اُمّتي تسع خصال: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، وما اُستكرهوا عليه، والطيرة، والوسوسة في التفكّر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد (أو بيد خ، أو بيديه خ)».((3)) والحديث مرفوعٌ كما هو مذكور في سنده، ويظهر من طبقة النهدي مضافاً إلى ما قيل فيه، هذا.
وروى شيخنا الصدوق في الخصال، والتوحيد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطّار((4)) - رضي الله عنه - قال: حدّثنا سعد بن عبدالله،((5)) عن يعقوب بن يزيد،((6)) عن حمّاد بن عيسى،((7)) عن حريز بن عبد الله،((8)) عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: «قال رسول
ص: 45
الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): رفع (وضع في التوحيد) عن اُمّتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما اُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفةٍ»((1)) وسنده صحيحٌ. واحتمال كونه وما قبله واحداً لا يرد.
وفي الفقيه: قال النبّي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «وضع عن اُمّتى تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفةٍ».((2))
وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى،((3)) عن إسماعيل الجعفي((4)) عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: «وضع عن هذه الاُمّة ستّ خصال»، وذكر نحوه (أي نحو ما في الخصال والتوحيد) إلى قوله:«وما اضطرّوا إليه».((5))
ورواه في البحار عن فضالة،((6)) عن سيف بن عميرة،((7)) عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: سمعته يقول: «وضع عن هذه الاُمّة ستّة: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا عليه».
ص: 46
وعن دعائم الإسلام: قال جعفر بن محمد(عَلَيْهَا السَّلاَمُ): «رفع الله عن هذه الاُمّة أربعاً: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وماجهلوا حتى يعلموا».((1))
و عن الاختصاص: قال أبو عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «رفع عن هذه الاُمّة ستّ»؛ وذكر مثل ما ذكر إسماعيل الجعفي عنه(عَلَيْهِ السَّلاَمُ).((2))
إعلم: أنّه بعد ما لا يمكن بالضرورة إسناد الرفع إلى المذكورات حقيقةً وإخباراً عن الواقع، لاستلزامه الكذب والإخبار عمّا هو خلاف الواقع، فلابدّ أن يكون إسناده إليها إمّا بتقدير المؤاخذة؛((3)) حتى يكون المرفوع المؤاخذة، والرفع مسنداً إليها.
وإمّا بلحاظ رفع المؤاخذة عليها وكونها مرفوعةً من باب نفي ما يقتضيه إثبات أمرٍ بنفي ذلك الأمر. وبعبارة اُخرى: رفع المؤاخذة برفع ما يمكن المؤاخذة عليه، ليكون مصحّح نفي المذكورات عدم المؤاخذة عليها.
وإمّا بلحاظ نفي الأثر الظاهر لكلٍّ منها، أو تمام الآثار المترتبة على کلّ منها، بنفي المؤثّر بلحاظ نفي الأثر، فيكون إخباراً عن عدم تأثير المؤثّر في إيجاد أثره، أو عدم كونه مؤثّراً مطلقاً.
وإذا لم يكن المتكلّم جالساً على كرسيّ التشريع يكون کلامه محمولاً على الإخبار والرفع التكويني وظاهراً فيه. وإذا كان شارعاً يكون کلامه على الصور الثلاث
ص: 47
الأخيرة ظاهراً في التشريع، وعلى الصورة الاُولى يكون ظاهرا في الإخبار عن الرفع التكويني. فاحتمالها مرجوح جدّاً لا يعبأ به. بل في الصورة الاُولى من الصور الثلاث إذا كان رفع المذكورات بلحاظ رفع المؤاخذة عنها أيضاً يكون ظاهراً في الإخبار عن الرفع التكويني لا الإنشاء والتشريع.
فإن قلت: إنّ ما ينبغي أن يكون مرفوعاً من قبل الشارع وإن كان هو الحكم الشرعي، إلّا أنّ لازم رفعه رفع المؤاخذة، فأخبر عن وجود الملزوم بوجود اللازم، فلا ينافي استفادة الرفع التشريعي من الحديث الشريف كون المراد من رفع المذكورات رفع المؤاخذة عنها.
قلت: هذا لا يستقيم؛ لأنّه إذا كان الغرض والمراد الأصلي الإخبار عن وجود الملزوم فكيف يكون المراد وجود اللازم؟ ولماذا لم يخبر عنه بلا واسطة اللازم؟
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الكلام جرى مجازاً، فاُريد الملزوم بالإخبار عن وجود اللازم.
وفيه: منع الظهور، كما لا يخفى.
هذا مضافاً إلى أنّ إسناد الرفع إلى هذه المذكورات، كما أفاده الشيخ(قدس سره)، بلحاظ رفع المؤاخذة لا يستقيم بالنسبة إلى جميعها؛ فإنّ رفع المؤاخذة بالنسبة إلى الثلاثة الأخيرة (الحسد والطيرة والوسوسة في التفكّر في الخلق) يصحّ بلحاظ رفع واحدة منها في عالم التشريع وفرضها كأن لم تكن، فلا يتعلّق بها حكمٌ يكون العبد مأخوذا بمخالفته، وقد كان فيها اقتضاء جعل الحكم والمؤاخذة عليه. وبعبارةٍ اُخرى: رفع المؤاخذة عليها بلحاظ رفعها وعدم لحاظها موضوعاً لحكمٍ في عالم التشريع مع وجود اقتضاء ذلك فيه.
وأمّا «ما لا يطيقون»، فلا يصحّ تعلّق الرفع به بلحاظ رفع المؤاخذة، لعدم صحّة المؤاخذة على ما لا يطيق - فعلاً كان كما في الواجبات، أو تركاً كما في المحرّمات - فلابدّ من أن يكون رفعه بلحاظ رفع حكمه لا المؤاخذة.
ص: 48
وأمّا النسيان،((1)) والخطأ،((2)) وما اضطرّوا إليه، وما استكرهوا عليه، فلا مانع من كون المراد من رفعها رفع المؤاخذة والعقوبة عليها. كما لا مانع من كون المراد من رفعها عدم ترتّب أثرها الظاهر، أو آثارها الظاهرة عليها.
وعلى هذا، لا يتمّ إطلاق القول بأنّ رفع المذكورات في الحديث يكون بلحاظ رفع المواخذة عليها، لعدم تمامية ذلك في بعضها، ک- «ما لا يطيقون».
وأمّا إن كان المراد رفع أظهر الآثار، فهو بالنسبة إلى الثلاثة الأخيرة وإن كان هو «الحرمة»، وبالنسبة إلى ما «لا يطيقون» «الإلزام»، لكن ليس لما اضطرّوا إليه وما استكرهوا عليه أثرٌ خاصٌ ظاهرٌ، بل يختلف بالنسبة إلى الموارد الّتي ينطبق عليها عنوان الاضطرار والإكراه، فليس لهما أثرٌ ظاهرٌ بهما، بخلاف الحسد، والطيرة، والوسوسة، وما لا يطيقون.
والّذي ينبغي أن يقال: إنّه بعد التأمّل في الحديث الشريف يعلم أنّ إسناد الرفع إلى جميع المذكورات ليس على سياقٍ واحدٍ، فينبغي إفراد كلّ واحدٍ منها عن الآخر.
ونقدّم الكلام في غير «ما لا يعلمون» فنقول: أمّا رفع الطيرة، والحسد، والتفكّر في الخلق، فالمراد برفعها رفع هذه العناوين حقيقةً في عالم التشريع، وعدم ملاحظتها موضوعاً لحكم شرعيّ مع وجودها في عالم التكوين. فهذه الثلاثة جعلت في عالم التشريع كأن لم تكن وكما لو لم توجد، فلم يترتّب عليها حكمٌ، ولم يتعلّق بها نهيٌ.
ص: 49
فالمراد من رفعها رفع حكمها بلسان نفي موضوعها. وبعبارةٍ اُخرى: رفع تأثيرها في الحكم بتحريمها باعتبار نفيها وعدمها.
وأمّا ما اضطرّوا إليه، وما استكرهوا عليه، والنسيان، والخطأ، فيمكن أن يكون رفعها برفع الحكم التكليفي أو رفع جميع الآثار حتى يشمل آثارها التكليفية والوضعية.
وهذا هو الأقرب وإن كان ربّما يستبعد ذلك بملاحظة أنّ رفع الحكم الوضعيّ فيما اضطرّوا إليه يكون على خلاف الامتنان، مع أنّ الحكم امتنانيٌّ لأجل التوسعة على العباد.
ولكن يمكن دفع هذا بأنّ الاضطرار تارة يكون إلى النتيجة، كما لو باع ماله لتحصيل نقدٍ يدفعه للظالم ليخلّص ابنه من السجن، أو احتاج إليه لدفعه إلى غريمه، ففي مثل هذا رفع الاضطرار مخالفٌ للامتنان. بخلاف ما إذا اضطرّ إلى السبب، كالبيع مثلاً، فإنّه يكون رفعه موافقاً للامتنان. والمراد بما اضطرّ إليه هو القسم الثاني، لا الأوّل.
لا يخفى عليك الفرق بين الخطأ والنسيان، وبين ما اضطرّوا إليه وما استكرهوا عليه من جهة وجود الموصول في الأخيرين وعدمه في الأوّلين، فيشمل رفع الخطأ والنسيان الأحكام الوجوبية والتحريمية. إلّا أنّ النسيان في طرف الفعل الواجب علّة لتركه، لكون الفعل الاختياري متوقّفا على التصوّر والتصديق والعزم والإرادة والاختيار فنسيانه علّةٌ لتركه؛ وفي طرف الحرام والترك لا يكون متعلّق النسيان الفعل، مثل شرب الخمر، ولا يكون مستنده نسيان الفعل بل يكون مستنداً إلى نسيان الحكم الكلّي أو الجزئي أو سبب الحكم.
ص: 50
إذا نسي واجباً ليس له قضاء ولا يترتب على تركه - شرعاً - أمرٌ آخر كالكفّارة، فلا يشمله حديث الرفع، لما قلنا من أنّ المستفاد منه الرفع التشريعي ولا يدلّ على رفع المؤاخذة، لأنّها وعدمها من الاُمور التكوينية. وأمّا إن كان تركه موجباً لوجوب القضاء أو كان ذلك مشكوكاً فيه، ففي دلالة رفع النسيان في الحديث على عدم وجوب القضاء إشكالٌ. والأقوى عدم شموله؛ لأنّه متوقّفٌ على دلالته على جعل الترك والعدم كالوجود، وهو متوقّفٌ على صحّة تعلّق الرفع بالعدم وهو غير معقولٍ، لأنّ العدم ليس شيئا حتى يرفع، فلا يتعلّق الرفع إلّا بالأمر الموجود دون المعدوم، فالعدم لا يكون رافعاً ولا مرفوعاً ولا يؤثّر ولا يتأثّر ولا يحصّل ولا يحصّل.
لا يقال: إنّ معنى رفع العدم تشريعاً - بهذه القرينة العقلية - رفع حكمه الشرعي.
فإنّه يقال: ليس العدم موضوعاً لحكمٍ حتى يصحّ رفعه بلسان رفع موضوعه، وثبوت القضاء مترتّبٌ على فوت الوجود.
هذا مضافاً إلى أنّه لو قلنا بشمول حديث الرفع لأمثال هذا المورد، فلا يشمل قضاء الصلاة لخروجه عن تحته بما ورد بالخصوص على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنسيان والنوم وغيرهما، هذا.
وربما يقال لوجه منع شمول الحديث لما إذا كان الترك موجباً للقضاء: إنّ معنى رفع النسيان والخطأ وتنزيلهما منزلة العدم هو: أنّ الفعل الصادر على أحد الوجهين يكون كأن لم يصدر على هذا الوجه.
وهذا المعنى بظاهره فاسدٌ، لاستلزامه ترتيب آثار العمد على الفعل الصادر عن الخطأ والنسيان، وذلك ينافي الامتنان والتوسعة، فلابدّ وأن يكون المراد من رفع الخطأ والنسيان رفع الفعل الصادر عن الخطأ أو النسيان كشرب الخمر - والعياذ بالله - ، يعني جعل الفعل كالعدم وكأنّه لم يصدر من هذا الشخص.
ص: 51
فيوافق مفاده مفاد رفع ما استكرهوا عليه وما اضطرّوا إليه وما لا يطيقونه، فإنّ المرفوع في هذه الثلاثة هو الفعل الّذي وقع عن الإكراه والاضطرار.
ثم إنّ الأحكام وضعيةً كانت أو تكليفيةً إمّا أن تكون مترتّبةً على الفعل بلحاظ صرف الوجود أو بلحاظ مطلق الوجود، فإن كانت مترتّبةً عليه بلحاظ مطلق الوجود كشرب الخمر، فلا ريب في سقوط الحكم بمجرّد النسيان أو الخطأ كما أنّه باقٍ على تنجّزه بالنسبة إلى سائر أفراده. وأمّا إن كانت مترتّبةً عليه بلحاظ صرف الوجود، ففي شمول حديث الرفع له إشكالٌ، فإنّ المنسيّ ليس محكوماً بحكمٍ حتى يرفع ويكون المراد من رفعه رفع حكمه، بل المتعلّق للوجوب صرف الوجود وفرد الكلّي وهو لم يصر منسيّا، وليس المنسيّ شيئاً حتى يكون محكوماً بحكمٍ ويكون المراد من رفعه رفع حكمه.
وحاصل ما ذكر: أنّ الأحكام الوجوبية حيث تكون مترتّبةً على موضوعاتها بلسان صرف الوجود، فلا ترفع بنسيانها فيما إذا لم يكن النسيان مستوعباً لتمام الوقت، وكذلك إن لم يكن مستوعباً لتمامه لأنّ المنسيّ ليس محكوماً بحكمٍ حتى يراد برفعه رفعه. فيختصّ رفع النسيان والخطأ بالأحكام التحريمية.((1))
ص: 52
إذا نسي جزءاً من الصلاة فهل مقتضى رفع النسيان رفع جزئيته أو لا؟
ربما يقال: بأنّ لازم الأمر بمجموع الوجودات المعيّنة واعتبارها أمرا واحداً تعلّق أبعاضه بها؛ لأنّ کلّ واحد من الأجزاء يكون متعلّقاً لبعض الأمر وواجباً بالأمر المتعلّق بالكلّ الشامل لجميع الأجزاء الملحوظة بلحاظه. وهذا معنى القول بكون الجزء واجباً بالوجوب الضمني كما ذكرناه في مبحث مقدّمة الواجب، فإنّ الجزء ليس واجبا بالوجوب الغيري ولا النفسي، ولكنّه واجب بالوجوب الضمني. وعلى هذا لامانع من رفع جزئية الجزء المنسيّ وجوبه برفعه. ولا فرق في كون المرفوع جزء المأمور به أو کلّه، فيرفع بالأوّل بعض الحكم، وبالثاني کلّه. وإذا رفع بعض الحكم المتعلّق بهذا الجزء يكون تمام المأمور به سائر الأجزاء فتبقى تحت الأمر.
وأظنّ أنّ هذا مراد شيخنا الاُستاذ(قدس سره) في الكفاية من كون حديث الرفع قاضياً برفع الجزئية؛ فإنّ منشأ انتزاع الجزئية هو بعض الحكم المتعلّق بهذا الجزء، وبعد رفع بعض الحكم برفع الجزء المنسيّ ترتفع جزئيته.
ولا يرد عليه: أنّ جزئية الجزء ليست منسيّةً حتى ترتفع بحديث الرفع بخلاف جزئية ما شكّ في جزئيته، فإنّ المجهول هو جزئية ذلك الشيء فترتفع.
فإنّ جزئية الجزء وإن لم تكن مرفوعة ابتداءً إلّا أنّها مرفوعةٌ برفع منشأ انتزاعها وهو بعض الحكم المتعلّق بهذا الجزء المنسيّ. وهكذا الكلام في جزئية ما شكّ في جزئيته، فإنّ الرفع لا يتعلّق بالجزئية لعدم كونها قابلة للرفع ابتداءً بل هو متعلّق ببعض الحكم المشكوك تعلّقه بهذا الجزء الّذي هو منشأٌ لانتزاع جزئيته، كما لا يخفى.((1)) هذا،
ص: 53
والأقوى عدم استفادة رفع جزئية الجزء من حديث الرفع، فإنّ المستفاد منه جعل ما وجد كالعدم، لا جعل ما لم يوجد كالموجود. هذا مضافاً إلى أنّ رفع جزئية الجزء في حال النسيان لا يفيد كون المأمور به ما بقي من الأجزاء، بل يرجع ذلك إلى عدم الإتيان بأصل المأمور به ورفعه في حال النسيان، وهو لا يقتضي رفعه بعد النسيان.
هذا کلّه في المرفوعات المذكورة في الحديث غير «ما لا يعلمون».
وأمّا الكلام في «ما لا يعلمون» الّذي هو المقصود من ذكر الحديث الشريف في المقام، فنقول فيه:
إعلم: أنّ الشيخ(قدس سره) قد أورد على كون المراد من رفع ما لا يعلمون رفع الحكم أوّلاً: بأنّ الظاهر من الموصول بقرينة السياق هو الموضوع، أي فعل المکلّف كشرب المائع الّذي لا يعلم أنّه شرب الخمر أو الخلّ، فلا يشمل الحكم المجهول للموضوع المعلوم. وثانياً: بأنّ تقدير المؤاخذة لا يلائم عموم الموصول للحكم والموضوع، أو خصوص الحكم؛ لأنّه لا معنى للمؤاخذة على نفس الحكم المجهول بخلاف الموضوع المجهول، فإنّه يمكن المؤاخذة عليه.((1))
والجواب عن الوجه الأوّل: أنّ قرينة السياق والعطف لاتقضي إلّا إثبات ما ثبت للمعطوف عليه للمعطوف أيضاً، أو نفي ما نفي عنه عن المعطوف. ولا يجب أن يكون المعطوف عليه والمعطوف من ماهيةٍ واحدةٍ. ففي المقام لا نحتاج إلى أزيد من كون «ما لا يعلمون» كغيره من المذكورات الّتي عطف عليها، ومثل هذا كثيرٌ في الكلمات.
ص: 54
وأمّا ما أفاده ثانياً، ففيه أوّلاً: أنّ الظاهر من هذه التعبيرات - كما قلنا - هو الرفع التشريعي لا التكويني، والمؤاخذة ليست من الاُمور التشريعية.
وثانياً: إن كان المراد من تقدير المؤاخذة تقدير (المؤاخذة على) في کلّ من المذكورات، فهو ممنوع. وإن كان المراد منه أنّ رفع المؤاخذة على هذه المذكورات كناية عن رفع ما يوجبها من التكاليف والأحكام، فيقال: لا حاجة إلى ذلك بعد إمكان إسناد الرفع إلى ما يوجبها.
فتلخّص: أنّه ليس في البين شيءٌ يمنع من شمول «ما لا يعلمون» للحكم المجهول؛ وقد قلنا سابقا: إنّ المبهمات كأسماء الإشارة والموصولات والضمائر إنّما وضعت للإشارة، وأنّ اللفظ الدالّ على الإشارة يكون فانياً في الإشارة، وهي فانيةٌ في المشار إليه وهو معنىً اسميٌّ مستقلٌّ، فلذا يصحّ أن يقع لفظ الإشارة محكوماً عليه وبه؛ وأنّ المشار إليه لابدّ وأن يكون متعيّناً بنحو من التعيين لعدم إمكان الإشارة إلى غير المتعيّن. فعلى هذا لو كان المشار إليه متعيّناً كجاء الّذي أبوه فاضلٌ - ممّا يكون متعيّناً بصلته - يكون المشار إليه هذا المتعيّن، وإن لم يكن له هذا التعيّن يكون المشار إليه جميع أفراد صلته، كقوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «ما لا يعلمون». فعلى هذا کلّه، يشمل «ما لا يعلمون» الحكم المجهول، والموضوع المجهول.
أقول: إلى هنا انتهى ما استفدنا من سيّدنا الاُستاذ الأعظم سيّد الطائفة وزعيم الفرقة المحقّة أعلى الله في فراديس الجنان درجاته في اُصول الفقه.
ونسأل الله تعالى أن يوفّقنا لما يحبّ ويرضى
ويصلّي على محمّدٍ وآله الطاهرين.
ص: 55
لمّا انتهى بحث سيّدنا الاُستاذ الأكبر(قدس سره) وتدريسه في بلدة قم المباركة عشّ آل محمد - صلوات الله عليهم أجمعين - إلى ما أفاد في حديث الرفع، ومنعته كثرة مشاغله وما صار على عاتقه من مهامّ الاُمور الإسلامية والوظائف العامّة وإصلاح اُمور المسلمين والذبّ عن الدين والسعي في إعلاء کلمة الله، عن إتمام مباحثه الاُصولية - رسمياً وتدريساً - ولم يتعرّض لروايات الباب إلّا لحديث الرفع، رأيت أن ألحق بما كتبته عنه سائر المباحث إلى آخر الكفاية واستفدت في ذلك ما اسندته في طي المباحث الى السيّد الاُستاذ(قدس سره) من تقريرات درسه ممّا أملاه على ثلّةٍ من الفضلاء في بلدة بروجرد وقد كتبها بعض أفاضل تلامذته حاشيةً على كفاية الاُصول - ممزوجاً بما يخطر ببالي القاصر - إن شاء الله تعالى، والله هو الموفّق والمعين. وكان الشروع في ذلك ليلة الخميس، السادس والعشرين من جمادى الاُولى، من شهور سنة 1422 الهجرية القمرية في بلدة دماوند، فنقول:
ص: 56
ومن الروايات الّتي استدلّ بها على البراءة: الحديث المعروف بحديث الحجب وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن زكريا بن يحيى، عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم».((1))
ولا يخفى عليك: أنّ ما يحتمل أن يكون المراد من الحديث وجوهٌ يستدلّ ببعضها على المطلوب.
أحدها: أن يكون المراد منه: أنّ کلّ شيءٍ من الاُمور الواقعية الّتي اقتضت الحكمة الإلهية عدم علم العباد بها وحجب عنهم العلم بها، فهو موضوعٌ عنهم((2)) إمّا بالوضع التكويني؛ لأنّ العباد عاجزون عن معرفة بعض الحقائق المحجوبة عنهم، لعلوّ هذه الحقائق وارتفاعها عن وصول فهم البشر إليها.
وإمّا أن يكون المراد أنّهم غير مكلّفين بفهم ما حجب الله علمه عنهم، فليس عليهم أن يتكلّفوا فهماً لوقوعهم بذلك في معرض الضلالة والاعتقادات الباطلة.
وبعبارة اُخرى: معنى الحديث الإرشاد إلى عدم كون الحقائق العالية في معرض وصول عقل البشر وعلمهم إليه، ودفع توهّم كونهم مكلّفين مثلاً بمعرفة كنهه تعالى. وهذا وجهٌ في الحديث، لا مجال لردّ احتماله.
ص: 57
ثانيها أن يكون المراد: أنّ التكاليف المستور علمها عن جميع العباد موضوعة عنهم (دون ما كان مستوراً عن بعضهم دون بعض). فالملاك جهل الجميع دون البعض، لإمكان رجوع الجاهل منهم إلى العالم ورفع جهله بالرجوع إليه، ولازم ذلك وضعه عمّن لا يمكن له الرجوع إلى غيره ورفع جهله به.
ثالثها: أن يكون المعنى: أنّ کلّ تكليفٍ صار مجهولاً للعبد ومحجوباً عنه لعدم وصوله إليه وعدم الطريق إليه، فهو موضوعٌ عنه.
ولا يخفى: أنّ النتيجة على المعنى الثاني والثالث واحدةٌ.
ولكن أظهر الاحتمالات بملاحظة إسناد الحجب إلى الله تعالى هو الاحتمال الأوّل، فيكون الحديث مرتبطاً بالمعاني العالية في باب المعارف القدسية ممّا کلّما نتكلّم فيه ونتصوّر أنّه هو كذلك، فلا يكون كما نتصوّره، بل هو أقدس وأعلى وأجلّ وأعظم منه.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ المناسب لقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «فهو موضوع عنهم» المعنى الثالث والثاني دون الأوّل، فتدبّر.
ومنها: الحديث المنقول في الكفاية: «كلّ شيءٍ لك حلال حتى تعرف أنّه حرام بعينه».((1))
وجه الاستدلال به: دلالته على حليّة ما لم تعرف حرمته ولو كان من جهة عدم
ص: 58
الدليل على حرمته (سواءٌ كانت الشبهة موضوعيةً أو حكميةً)، وعدم الفصل قطعاً بين الحليّة وعدم وجوب الاحتياط، لمنافاة الحكم بالحليّة مع إيجاب الاحتياط. وعدم الفصل بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية وعدم وجوبه في الشبهة الوجوبية، للإجماع على عدم وجوبه في الشبهة الوجوبية.
ومنها: الخبر المرسل: «الناس في سعة ما لم يعلموا».((1))
وجه الاستدلال به (بغضّ النظر عن ضعفه بالإرسال)، سواء كان لفظ «ما» فيه موصولة أم مصدرية، أنّهم في سعة.
فإن كانت «ما» موصولة يدلّ على أنّهم في سعة ما هو مجهول الحكم ما لم تعلم حرمته.
وإن كانت مصدرية يدلّ على أنّهم في سعة ما داموا غير عالمين، فيدلّ على عدم وجوب الاحتياط، لأنّ الاحتياط لو كان واجباً لما كانوا في سعةٍ أصلاً.
فيدفع به ما هو ظاهر في وجوبه، لأنّ الحديث نصٌّ في كونهم في سعةٍ، وما يدلّ على وجوب الاحتياط - لو قلنا بدلالته - ظاهرٌ فيه، فترفع اليد عن الظاهر بالأظهر والنصّ.
ثم إنّه قد استشكل الشيخ(قدس سره) على الاستدلال بالآيات والروايات: بأنّه لو قبلنا دلالتها على المطلوب فإنّما تدلّ على عدم التكاليف المجهولة - الّتي لم يعلم المکلّف بها - بالعقل أو النقل. ولكن إذا فرض وجود دليلٍ معتبرٍ على وجوب الاحتياط، كما يقوله
ص: 59
الأخباري، فيخرج به «ما لا يعلمون» عن كونه كذلك وينقلب إلى ما يعلمون، ويكون ما دلّ على وجوب الاحتياط وارداً عليه نافياً لموضوعه وموجباً لانقلاب موضوعه.((1))
وفيه: أنّ ذلك يرد على الاستدلال لو كان الاحتياط واجباً نفسياً، وأمّا إذا كان طريقياً فتقع المعارضة بين ما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط مثل: قوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «الناس في سعة...»، وما يدلّ على وجوبه؛ لأنّ الأوّل يدلّ على عدم الضيق من جهة ما لا يعلم، والثاني يدلّ على الضيق من جهته بوجوب الاحتياط الطريقي - الّذي وجب للجهل وعدم العلم بالواقع - فيقع التعارض بينهما. ولا ريب في أنّ الأوّل نصٌ في عدم وجوب الاحتياط كما مرّ.
لا يقال: يمكن الجمع بينهما بحمل ما يدلّ على وجوب الاحتياط على وجوبه في الشبهات التحريمية، وتقييد ما يدلّ على عدم وجوبه مطلقاً.
فإنّه يقال: إنّ تخصيص ما يدلّ على وجوب الاحتياط - على القول به - بالشبهة التحريمية تخصيصٌ بلا مخصصٍ. مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: إنّه من التخصيص بالأكثر المستهجن، لكثرة الشبهات التحريمية وقلّة الوجوبية. هذا مضافاً إلى أنّ بعض الروايات الدالّة على البراءة وعدم وجوب الاحتياط وارداً في خصوص الشبهات التحريمية نصّاً أو ظاهراً، وإنّما نقول به في الشبهات الوجوبية لعدم الفصل والإجماع.
ومنها: ما أرسله الصدوق عن مولانا الصادق(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: «كلَّ شيءٍ مطلقٌ حتّى يرد فيه نهي».((2))
ص: 60
ودلالته على المطلوب موقوفةٌ على كون المراد من الورود: العلم - أو ما بحكمه - بالنهي حتى يكون مفاده بيان حكم مجهول الحكم والمشكوك في كونه منهيّاً عنه. بخلاف أن يقال: إنّ المراد من الورود الورود الأوّلي الواقعي، فإنّه إخبارٌ عن أنّ الأشياء بحسب الواقع ونفس الأمر إنّما تكون على الإباحة حتى يرد فيها النهي، فيكون مفاده الإخبار بأنّ الأصل قبل الشرع هو الإباحة لا الحظر. وحيث إنّ الظاهر من حال الشارع كونه في خطاباته وإلقاءاته الكلّية في مقام التشريع دون الإخبار فلا يبعد استظهار كون المراد منه: بيان الحكم الظاهري وتكليف الشاكّ في الحكم الواقعي.
ولكن يمكن أن يقال: إنّه على الاحتمال الثاني أيضاً يمكن كونه في مقام التشريع وبيان الإباحة الشرعية لجميع الأشياء حتى يكون الحديث دليلاً على أنّ الأصل الأوّلي العقلي وإن كان الحظر إلّا أنّ الأشياء کلّها بحكم الشرع محكومةٌ بالإباحة الواقعية الشرعية حتى يرد النهي من الشارع وتصير محكومةً بالحرمة. وعليه يكون ما ورد من النهي عن الأشياء مخصِّصا لعموم مثل هذا الدليل. ولا تعارض بينه وبين أدلّة الاحتياط ولا ما يدلّ على الأحكام الظاهرية؛ لأنّ موردهما الشكّ في النواهي الواردة على هذا الأصل، بخلاف ما إذا كان المراد الاحتمال الأوّل فإنّه يقع التعارض بينه وبين أدلّة الاحتياط.
وكيف كان، فالقائل باستظهار الأوّل هو الشيخ،((1)) والقائل بالثاني هو المحقّق الخراساني.((2)) وقد أورد هو على نفسه بأنّ مطلوب من يقول بالأوّل يحصل على القول
ص: 61
بالثاني أيضاً؛ لأنّه عليه بمقتضى الحديث إمّا أن يكون عالماً بورود النهي فالحكم الحظر، وإمّا أن يكون عالماً بعدم وروده فالحكم الإباحة، وإن شككنا في وروده فبضمّ أصالة عدم الورود تثبت الإباحة. فنتيجة الاستظهارين تكون واحدةً.
وأجاب عن هذا الإيراد بأنّ الحكم بالإباحة على الأوّل يكون لأجل أنّه مجهول الحرمة ظاهراً وهو حكمٌ ظاهريٌ وعلى الثاني يكون بعنوان أنّه لم يرد فيه النهي واقعاً.
فإن قلت: لا فرق في الحكم بالإباحة بين أن يكون بهذا العنوان أو بذاك، فالمكلّف غير ممنوع من ارتكاب ما وقع فيه. قلت: يحصل الفرق في مجهولي التاريخ - إذا ورد النهي في زمانٍ ثم نسخ بالإباحة في زمانٍ آخر، أو بالعكس وجهل المتقدّم والمتأخّر منهما - حيث لا يمكن إجراء الأصل لإثبات کلّ واحدٍ منهما للتعارض، كما عليه الشيخ، أو لعدم تحقّق أركان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، فعلى القول الأوّل فيما هو مفاد الحديث نقول بالإباحة، و على الثاني يشكل إجراء استصحاب عدم ورود النهي، لما ذكر على المبنيين.
فإن قلت: إن لم يمكن إجراء استصحاب عدم ورود النهي في الفرض، يمكن إثباته بعدم القول بالفصل بين المشتبهات.
قلت: إثبات الإباحة لهذا الفرض لإثباتها في غيره بالاستصحاب بتوسيط عدم القول بالفصل، لايصحّ إلّا على القول بالأصل المثبت؛ لأنّ هذه الواسطة ليست بأمرٍ شرعيٍّ يثبت بالأصل الجاري في غير محلّ الفرض، كما هو المفروض.
ولكن يمكن أن يقال: نعم، يتمّ ما ذكر لو كان الإيراد مبنيّاً على القول بعدم الفصل بين المشتبهات، فيلزم إمّا رفع اليد عن الاستصحاب في مجهولي التاريخ والقول بعدم إثبات الإباحة مطلقاً، أو القول بإجرائه فيه والقول بالإباحة مطلقاً، فتأمّل جيّداً.
ص: 62
اُمور مهمّة((1))
لا تجري أصالة البراءة إذا كان في البين أصلٌ موضوعي يحرز به الحكم إثباتاً أو نفياً، سواءٌ كان منشأ الشكّ أمراً كان بيانه من شؤون الشرع مثل قابلية الحيوان للتذكية وعدمها، فإنّ مثلها لا يعلم إلّا ببيان الشارع، أم كان الشكّ في أمرٍ خارجيٍّ كالشكّ في وقوع التذكية على حيوانٍ اُحرزت قابليته لها.
والوجه في ذلك: أنّ جريان الأصل الموضوعي مانعٌ عن بقاء الواقعة مجهولة الحكم، ويجعلها معلومة الحكم فلا تشملها أدلّة البراءة النقلية كما لا تشملها أدلّة البراءة العقلية، لأنّها إنّما تجري في مورد فقدان البيان والأصل الموضوعي بيانٌ لها.
وبالجملة: بعد قيام الدليل أو الأصل المعتبر ينتفي ما هو الموضوع لإجراء البراءة وهو عدم وجود منجّزٍ للواقع دون ما إذا وجد، سواء كان هو العلم أو ما يقوم مقامه من دليلٍ معتبرٍ شرعيٍّ أو أصل معتبرٍ.
وعلى هذا، إذا شككنا في حيوانٍ - ذبح بفري أوداجه الأربعة وسائر الشرائط - من جهة قابليته للتذكية الّتي هي أيضاً من شرائط التذكية، لا تجري فيه أصالة البراءة عمّا يترتّب على غير المذكّى من الحرمة، لورود أصلٍ موضوعيٍ عليها وانتفاء الشكّ في حرمته بالعلم بها أو ما يقوم مقام العلم شرعاً وهو استصحاب عدم وقوع التذكية على الحيوان المذكور.
لا ريب في حسن الاحتياط في الشبهات التحريمية والوجوبية العبادية وغيرها، إلّا
ص: 63
أنّه في الشبهة الوجوبية لمّا كان الاحتياط لا يتحقّق إلّا بالإتيان بالفعل بجميع أجزائه وشرائطه، يشكل تحقّقه إذا كان عبادياً ودار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب، بل بين الوجوب وغير الحرام، لأنّ من الشرائط المعتبرة فيها نيّة القربة وهي تتوقّف على العلم بالأمر المفروض انتفاؤه.
ورد ذلك تارة:((1)) بأنّ الأمر بالفعل الّذي يؤتى به احتياطاً ولاحتمال كونه متعلّقاً لأمر المولى وإن كان لا يعلم تعلّق الأمر به بعنوانه الأوّلي، لكنّه متعلّق به بعنوان الاحتياط لحسنه المستتبع للأمر به بقاعدة الملازمة، ويكفي في وقوعه عبادةً بنيّة القربة الإتيان به بقصد إطاعة ذلك الأمر.
ورد هذا: بأنّ تعلّق الأمر الاحتياطي بالفعل فرع تحقّق الاحتياط به، ومادام لم يثبت ذلك لم يثبت الأمر به، فتحقّق الاحتياط بالفعل من مبادئ الأمر به ولا يتحقّق الأمر بدونه، وتحقّق الأمر به متوقّفٌ على تحقّق الاحتياط به.
هذا مضافاً إلى أنّه يقال:((2)) إنّ الأمر بالاحتياط ليس أمراً مولوياً يترتّب على الإتيان به الثواب والقربة، بل هو إرشاديٌ، كالأمر بالإطاعة، ولا يوجب إتيان الفعل بقصده القربة والامتثال؛ لأنّ الأمر الحقيقيّ الّذي موافقته بقصده توجب القربة هو الأمر المتعلّق بالفعل الداعي إليه والّذي يكون محرّكاً للعبد نحوه، والأمر بالاحتياط إرشادٌ إلى حسن الإتيان بالفعل المحتمل كونه مأموراً به، كالأمر بالطاعة، غير أنّ الثاني إرشادٌ إلى الفعل المعلوم كونه مأموراً به، والأوّل إرشادٌ إلى المحتمل كونه كذلك. وبالجملة: حسن الاحتياط لا يكون كاشفاً عن تعلّق الأمر المولويّ به بنحو اللمّ، كما أنّ ترتّب
ص: 64
الثواب عليه لا يكون كاشفا بنحو الإنّ، بل هو نحوٌ من الانقياد والطاعة لو لم يصادف الواقع ويستحقّ فاعله المدح والثواب، فتأمّل.
وتارة اُخرى يقال: بأنّ الاحتياط - كما أفاده الشيخ(قدس سره) - هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة، فمعنى الاحتياط بالصلاة: الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة، فأوامر الاحتياط تتعلّق بهذا الفعل وحينئذ فيقصد المکلّف فيه التقرّب بإطاعة هذا الأمر، ومن هنا تتّجه الفتوى باستحباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلِّد كونه ممّا شكّ في أنّه عبادة ولم يأت به بداعي احتمال المطلوبية. ولو اُريد بالاحتياط معناه الحقيقي وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبية لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلّا مع التقييد بإتيانه بداعي الاحتمال حتى يصدق عليه عنوان الاحتياط، مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه. فعلم أنّ المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نيّة الداعي.((1))
وأورد عليه: سيّدنا الاُستاذ(قدس سره) في الحاشية على الكفاية.
أوّلاً: بأنّ ذلك مستلزم للقول بخروج العبادة عن كونها عبادة وصيرورتها واجباً توصّلياً، مع أنّ موضوع البحث هو الفعل التعبّدي لا التوصّلي.
وثانياً: بعدم الدليل على حسن الاحتياط في العبادات بدون قصد القربة فيها، لأنّه في العبادة ليس من الاحتياط بشيء.
وثالثاً: بأنّ ذلك التزامٌ بالإشكال، وهو عدم إمكان الاحتياط في العبادة.
ورابعاً: بأنّ ذلك مستلزمٌ لما لا يلتزم به الشيخ(قدس سره) أيضاً من كفاية الامتثال بنفس العمل بغير قصد القربة ولو أتى به رئاءً أو بداعٍ نفسانيٍّ.((2))
ص: 65
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ كفاية الاحتياط بمجرد الإتيان بالفعل المطابق للعبادة يستفاد من ترغيب الشارع في العبادة مع عدم إمكان الإتيان به بنيّة القربة بدلالة الاقتضاء. وما ذكر غاية ما يمكن الإتيان به في العبادات احتياطاً، فتأمّل.
هذا کلّه على القول بكون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشرائط والأجزاء المعتبرة فيها مأخوذةً في متعلّق الأمر وواقعة تحت الأمر بها كسائر الأجزاء والشرائط. وأمّا على القول بعدم أخذ قصد التقرّب ونيّة القربة في متعلّق الأمر، والبناء على أنّ متعلّق الأمر فيها أوسع ممّا يحصل به الغرض، غير أنّ العقل يدلّنا على اعتبار القصد المذكور في حصول الغرض، فيكون الإتيان بالاحتياط - كما أفاده في الكفاية - بمكانٍ من الإمكان، ضرورة التمكّن من الإتيان بما احتمل اعتباره في المأمور به بتمامه وكماله، غاية الأمر أنّه يلزم عليه أن يأتي به على نحو يكون محصّلاً للغرض، ويكفي في ذلك الإتيان به بداعي احتمال الأمر واحتمال المحبوبية.((1))
وفي تقريرات سيّدنا الاُستاذ(قدس سره): أنّه إذا قلنا بكفاية احتمال الأمر في حصول الغرض، فلا فرق بين أن تكون نيّة القربة مأخوذةً في متعلّق الأمر أم لا تكون مأخوذةً فيه، وكذلك إن قلنا بعدم الكفاية وقلنا بلزوم الجزم في القصد في حصول الغرض لا فرق بين القولين والوجهين.((2)) انتهى.
وبعبارة اُخرى نقول: إنّ العبادية والقربة إن كانت تتحقّق بإتيان الفعل بداعي احتمال الأمر به، فهي كما تتحقّق إذا لم يكن قصد القربة مأخوذاً في المأمور به وأتى به احتياطاً وبداعي احتمال أمر المولى، تتحقّق إذا أتى بما تكون القربة والعبادية مأخوذة فيه باحتمال الأمر به.
ص: 66
وبعبارة ثالثة: يتحقّق الاحتياط بفعل - لو كان هو المأمور به كان قصد القربة مأخوذاً فيه بنحو الجزئية أو الشرطية - باحتمال الأمر به، وإن لا يكفي احتمال الأمر في تحقّق الاحتياط وحصول الغرض، فلا فرق بين القول بأخذ القربة في المأمور به في العبادة والقول بعدم اعتباره، فتدبّر.
ثم إنّه لا يخفى عليك فساد التمسّك((1)) - لإثبات جريان الاحتياط في العبادات - بأخبار «من بلغه ثواب...»؛ فإنّ هذه إن قيل بدلالتها على استحباب العمل الّذي ورد في الترغيب عليه خبرٌ ضعيف بعنوان نفسه أو بعنوان كونه مورداً للخبر، فهذا ليس من الاحتياط بشيءٍ. وإن قيل بدلالتها على حسن الاحتياط، فيعود الإشكال في العبادات.
ص: 67
حيث انتهى الكلام إلى هذه الأخبار فلا بأس بإجراء الكلام في دلالتها، فنقول: قد أفتى المشهور - كما أفاده في الكفاية((1)) - باستحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب كسائر المستحبّات، فتستكشف بطريق الإنّ ووجود المعلول العلّة، أي يستكشف بالثواب المترتّب على نفس الفعل استحبابه الّذي هو العلّة لترتّب الثواب عليه استحباباً شرعيّاً كسائر المستحبات، فهو يكون مأموراً به بالأمر الندبي. وهذا ظاهر صحيح هشام بن سالم المرويّ في المحاسن عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، قال: «من بلغه عن النبيّ شيءٌ من الثواب فعمله، كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لم يقله»،((2)) فإنّ الظاهر منه ترتّب الثواب على نفس العمل لا بعنوانه الثانوي وإتيانه احتياطاً وانقياداً. خلافاً للشيخ(قدس سره)،((3)) فإنّه يرى أنّ ترتّب الثواب على العمل ليس بعنوانه الأوّلي بل بعنوان الانقياد والإطاعة، وعليه يستكشف بطريق الإنّ أنّ الاحتياط في موردٍ قام الخبر عليه يكون مستحبّاً وإن كان الخبر ضعيفاً، وذلك بدعوى دلالة بعض أخبار الباب على ذلك، ففي بعضها: «من بلغه ثواب من الله
ص: 68
عزّ وجلّ على عملٍ فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اُوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه».((1))
ولكن يمكن أن يقال بعدم التنافي بين الخبرين، لعدم تقيّد صحيح هشام فهو مطلق في ترتّب الثواب وإن لم يكن احتياطاً والتماساً لذلك الثواب، وعدم استفادة كون الثواب مقيّداً بكونه ملتمساً له.
هذا مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: إنّ أخبار الباب باختلاف مضامينها تدلّ على الترغيب في فعل ما ورد الخبر بترتّب الثواب عليه ولا حاجة إلى استكشاف الأمر الندبي بطريق الإنّ لأنّه لا موقع للترغيب إلّا إذا كان العمل مطلوباً ومحبوباً عند من يرغِّب إليه، وهذا هو الاستحباب. فلا يلزم في إثبات الاستحباب الأمر بالفعل، كما لا يجب ذلك في إثبات الوجوب، وكذا الحال في النهي.
وبعد ذلك کلّه يمكن أن يقال: إنّ استفادة الاستحباب من هذه الأخبار تدور مدار استفادة كونها في مقام التشريع لا الإخبار، وما هو الظاهر منها أنّها إخبار عن سعة تفضّل الله على عباده، وأنّه لا يخيّب رجاء من رجاه.
ويمكن أن يقال: إنّ الترغيب إلى إتيان کلّ عملٍ بلغ عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) له ثوابٌ، يوجب ورود كثير من الأعمال المباحة عملاً وفي عالم الظاهر في دائرة العبادات والشرعيات واشتغال الناس بها وانصرافهم بها عن الاُمور الأصلية والمقاصد الشرعية، وبعيد من حكمة الشارع فتح باب ذلك.
ولذلك نقول: إنّ القدر المتيقّن من هذه الأخبار أنّ من بلغه ثواب على عمل ثبت رجحانه وجوباً أو ندباً، أو على ترك ثبت مرجوحيّته تحريماً أو تنزيهاً، فأتى بالأوّل
ص: 69
وترك الثاني التماساً لدرك الثواب الّذي بلغه عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يكون له هذا الثواب، والله هو العالم.
لا يخفى عليك أنّه على ما أفاد السيّد الاُستاذ(قدس سره) من أنّ النهي عبارة عن الزجر عن الفعل، ينحلّ الحكم إلى أحكام عديدةٍ. فعلى هذا، يجب ترك کلّ فردٍ كان اندراجه تحت ما تعلّق به الزجر معلوماً دون ما جهل كونه مصداقاً له، سواءٌ لاحظ الحاكم الطبيعة مرآةً للأفراد أو لاحظها بما هي هي.
ووجه ذلك أنّ الزجر عن الطبيعة - إذا لم تكن مقيّدةً بقيدٍ خاصّ - يشمل جميع أفرادها؛ لأنّ کلّ فردٍ منها يكون نفس الطبيعة مع مشخصّات زائدة عليها، فإذا كانت الطبيعة مزجورة عنها باعتبار كونها مبغوضةً للزاجر يكون کلّ فرد منها مزجوراً عنه، وإذن فلا وجه للتفصيل المذكور في الكفاية،((1)) فتجري البراءة في کلّ فردٍ شكّ كونه من الطبيعة.
نعم، على ما بنى عليه في الكفاية من أنّ معنى النهي هو طلب الترك، يمكن في مقام الثبوت أن يقال: إنّ النهي عن شيءٍ إذا كان بمعنى طلب تركه في زمانٍ أو مكانٍ - بحيث لو وجد في ذلك المكان أو الزمان ولو دفعةً لما امتثل أصلاً - كان اللازم على المکلّف إحراز أنّه تركه بالمرّة ولو بالأصل، فلا يجوز الإتيان بشيءٍ يشكّ معه في تركه إلّا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به.((2))
وبعبارة اُخرى: إذا كان الحاكم طلب ترك الطبيعة على النحو المذكور وشكّ في
ص: 70
شيءٍ في كونه من أفراد الطبيعة ومصاديقها، لا يجوز إجراء البراءة بالنسبة إليه؛ لأنّ مع الإتيان به لا يحصل اليقين بالامتثال. وهذا بخلاف ما إذا كان طلب منه ترك کلّ فردٍ منها، فإنّه لا يجب عليه ترك ما شكّ في كونه فرداً منها، ولا يجب عليه إلّا ترك ما علم أنّه فردها. إلّا أنّ الظاهر في مقام الإثبات كون النواهي على الصورة الثانية، فتجري على هذا المبنى أيضاً البراءة الشرعية والعقلية في الفرد المشكوك، والله هو العالم.
لا يخفى حسن الاحتياط مطلقاً حتى فيما قامت الحجّة على عدم الوجوب في الشبهة الوجوبية، أو عدم الحرمة في الشبهة التحريمية، سيّما إذا كان في الاُمور المهمّة كالدماء والفروج، فما دام احتمال فوت الواقع باقياً يحسن رعايته والإتيان بالمحتمل.
نعم، إذا كان ذلك مخلّا بالنظام وطرأ عليه عنوانٌ ثانويٌّ محرّمٌ فلا يجوز ولا يكون حسناً، ولكن إذا علم أنّ رعاية الاحتياط في أمر مّا ينتهي إلى ما يرضى به الشارع فهو حسن وعليه ينبغي قبل ذلك ترجيح بعض الاحتياطات احتمالاً أو محتملاً.
ص: 71
ص: 72
قال في الكفاية: إذا دار الأمر بين وجوب شيءٍ وحرمته لعدم نهوض حجّة على أحدهما تفصيلاً بعد نهوضها عليه إجمالاً ففيه وجوه.((1))
أقول: إنّ السيّد الاُستاذ(قدس سره) - على ما كتب عنه الفاضل المقرّر - أفاد بأنّ البحث تارة: يلاحظ بالنسبة إلى نفس الحكم الواقعي من الوجوب والحرمة من حيث تنجّزه وعدمه. واُخرى: يلاحظ بالنسبة إلى الشكّ في الحكم الواقعي وأنّه هل هو الحرمة أو الوجوب. وثالثة: بالنسبة إلى الالتزام القلبي.
وأفاد في المورد الأوّل بأنّه لا شبهة في تنجّز الحكم الواقعي للعلم التفصيلي بجنسه والعلم الإجمالي بنوعه، إلّا أنّه لمّا لم يكن نوع الحكم معلوماً بالتفصيل وكان مردّداً بين الحرام والواجب وباعتبار وحدة متعلّقهما ودوران الأمر بين المحذورين، لا يمكن الاحتياط. فلابدّ من الكلام فيما هو التكليف بحسب الظاهر وهو المورد الثاني وهو حكم الواقعة ظاهراً،((2)) وفيه وجوه:
أحدها: أن يكون الحكم في هذه الواقعة البراءة نقلاً وعقلاً، لعموم النقل وحكم العقل بقبح العقاب على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به.
ص: 73
ثانيها: وجوب الأخذ بأحد الحكمين تعييناً.
ثالثها: وجوب الأخذ به تخييراً.
رابعها: التخيير بين الفعل والترك عقلاً، مع التوقّف عن الحكم به رأساً في مقام الإفتاء.
أو مع الحكم بالإباحة شرعاً. والظاهر أنّ هذا هو الوجه الخامس.
والفرق بين الوجوه المذكورة: أنّ الأوّل يقتضي عدم تنجّز الحكم الواقعي، سواء كان وجوبياً أو تحريمياً، لأنّه لا يثبت بجريان البراءة حكم ظاهري.
ومقتضى الوجه الثاني الحكم الطريقي الظاهريّ المنجّز للحكم المجهول، فإنّه إن كان الواقع المجهول حراماً يتنجّز بذلك الحكم الظاهريّ. والوجه الثالث أيضاً كذلك، أي يقتضي حكماً طريقياً ظاهرياً. غاية الأمر أنّ الحكم الواقعي تنجّزه تابع لاختيار المکلّف ، فما اختاره من الحكمين يتنجّز عليه في صورة الإصابة، ويكون عذراً في صورة الخطأ، سواءٌ كان التخيير بدوياً أو استمرارياً.
والوجه الرابع لا يكون مقتضياً لعدم التنجّز بطريقٍ كان الوجه الأوّل مقتضياً له؛ لأنّه باعتبار البراءة النقلية إنّما يكون دالّا على عدم تنجّز الحكم الواقعي بمعنى عدم إيجاب الاحتياط الطريقي، فإنّ الحكم بصرف الاحتمال لا يكون منجّزاً، وباعتبار البراءة العقلية يكون دالّا على أنّ صرف الاحتمال لا يكون سبباً للتنجّز. وعلى هذا، فالعقاب على مخالفة المجهول يكون عقاباً بلا بيان.
أمّا الوجه الرابع، فهو أيضاً دالّ على عدم التنجّز، لكن لا باعتبار عدم سببية صرف الاحتمال للتنجّز؛ لأنّ الحكم الواقعى في مثل المقام معلومٌ بجنسه وإن كان بنوعه محتملاً، ومعلومية الحكم بجنسه تكفي في تنجّزه عقلاً، لأنّه إذا علم إجمالاً بحرمة شرب التتن مثلاً، ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فلا شبهة عند العقل بلزوم ترك الأوّل وفعل الثاني لمكان العلم الإجمالي، والمقام يكون كذلك، والدالّ على عدم تنجّزه
ص: 74
أمرٌ آخر وهو عدم إمكان الموافقة والمخالفة القطعيتين في المقام، وعدم ترجيحٍ بينهما عند العقل، وهو الحاكم بعدم التنجّز والتخيير بين الفعل والترك. فحكم العقل بالتخيير في المقام ليس من باب عدم تنجّز الحكم باعتبار كونه مشكوكاً بل باعتبار عدم إمكان الجري على طبق المعلوم إجمالاً.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ أصحّ هذه الوجوه هو الوجه الرابع، أي حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك، لعدم إمكان الاحتياط، وعدم الترجيح بين الفعل والترك. ولعدم الدليل على سائر الوجوه.
أمّا الوجه الثاني والثالث، فلا دليل يدلّ على وجوب الأخذ بأحدهما تخييراً أو تعييناً ظاهراً، من حيث كونه حكماً ظاهرياً وطريقاً إلى الواقع.
وأمّا الوجه الأوّل، فهو ضعيفٌ، لأنّ مجرى البراءة العقلية والنقلية ما إذا كان الحكم مشكوكاً فيه حتى من جهة جنسه، أمّا إذا كان معلوماً ولو بجنسه فلا تجري البراءة فیه، وإجراؤهما في طرفي العلم الإجمالي لا يجتمع مع العلم الإجمالي. غاية الأمر أنّ العقل لمّا يرى أنّه لابدّی من ارتكاب الفعل أو تركه وعدم الترجيح، بينهما يحكم بالتخيير.
ولا يتوهّم أنّ ما يدلّ على التخيير في باب تعارض الخبرين يدلّ على ذلك حتى يكون التخيير شرعياً، لأنّ حجّية الخبر إن كانت من باب السببية والموضوعية يدخل تعارض الخبرين في باب المتزاحمين فيقال بالتخيير، وليس هنا كذلك، لأنّه لا يكون في البين إلّا حكمٌ واحدٌ معلومٌ في الواقع. وإن كان من باب الطريقية فالقول بالتخيير فيه أو تعيين أحدهما مختصٌّ بخصوص مورده لقيام الدليل عليه، دون مقامنا هذا.
وأمّا القول بالإباحة الشرعية، فيمكن أن يوجّه بشمول مثل قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «كلّ شيءٍ لك حلالٌ حتى تعرف أنّه حرامٌ» له. وفيه: أنّ مثله إنّما يجري في غير مورد العلم الإجمالي بنوع التكليف والعلم التفصيلي بجنسه. مضافاً إلى أنّ شموله لمثل المقام بعد
ص: 75
حكم العقل بالتخيير لغوٌ لا فائدة فيه. ومضافاً إلى أنّ الحديث المذكور وأمثاله مثل: «كلّ شيءٍ مطلقٌ» لا يفيد إلّا نفي احتمال التحريم، ويبقى طرف الوجوب على حاله لا يشمله، فلا يكون دليلاً على إباحة ما علم بالإجمال وجوبه أو حرمته وجواز الفعل والترك فيه، فافهم.
هل يختصّ ما ذكر من النزاع بما إذا كان الواجب توصّلياً - كما اختاره الشيخ((1)) - لعدم إمكان المخالفة القطعية إذا كان كذلك، بخلاف ما إذا كان الواجب تعبّدياً لإمكان المخالفة القطعية لإمكان إتيان الواجب بغير قصد التقرّب والتعبّد، فإذا أتى به كذلك تتحقّق المخالفة القطعية، أي فعل الحرام وترك الواجب.
بل يمكن أن يقال: بأنّه إذا كان الواجب تعبّدياً واعتبرنا في نيّة القربة به الجزم وعدم كفاية الإتيان به احتمالاً ورجاءً، فتجب عليه الموافقة الاحتمالية بتركه، لأنّ بفعله تتحقّق المخالفة القطعية، لأنّه على فرض وجوبه غير مقدورٍ له لا يمكن له الإتيان به، فهو تاركٌ للواجب من غير اختيارٍ، وعلى فرض حرمته إن أتى به يكون فاعلاً للحرام فتتحقّق به المخالفة القطعية، بل على ذلك يتعيّن عليه تركه لدوران الأمر بين المخالفة القطعية والموافقة الاحتمالية.
ولكن يمكن أن يقال: إنّ ما هو الملاك في حكم العقل بالتخيير ليس هو عدم إمكان المخالفة القطعية كما إذا كان الواجب توصّلياً، بل الملاك عدم إمكان الموافقة القطعية وعدم إمكان التحرّز عن المخالفة الاحتمالية، وهو حاصلٌ إذا كان الواجب توصّلياً، وإذا كان تعبّدياً أيضاً لا يمكن الموافقة القطعية ولا التحرّز من المخالفة
ص: 76
الاحتمالية، فإذا لم يكن ترجيح للفعل أو الترك على الآخر، يتخيّر المکلّف بينهما، ولا فرق في ذلك بين كون الواجب توصّلياً أم تعبّدياً.
وإن كان هنا ترجيح معلوماً لأحدهما دون الآخر، فلابدّ من الأخذ بذي المرجّح.
وأمّا إذا لم يكن الترجيح معلوماً وكان محتملاً، مثلاً: إذا كان الوجوب المحتمل في المقام آكد من الحرمة بحيث لو وقع التزاحم بينه وبين الحرام يقدم عليه فهل يوجب ذلك تقديمه والأخذ به، أو كان الأمر بالعكس وكانت الحرمة كذلك؟ فيه وجهان:
وجه التخيير: أنّ مجرّد احتمال الترجيح لا يوجب تعيين ما يحتمل ترجيحه، لأنّه لا يجعله أقرب من الآخر إلى الواقع. واحتمال كونه هو الواقع لا يرجّح بذلك على احتمال كون الآخر واقعاً.
ووجه التعيين: استقلال العقل بالتعيين، كما هو كذلك في دوران الأمر بين التعيين والتخيير.((1))
أقول: يمكن منع ذلك؛ لأنّه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالعقل مستقلّ بالتعيين لأنّ الإتيان بالطرف الّذي هو مأمورٌ به متعيّناً أو مخيّراً بينه وبين غيره موجبٌ للقطع بأداء التكليف، بخلاف المقام فإنّ الإتيان بذي الترجيح المذكور لا يوجب القطع بالامتثال وأداء الواقع، فكيف يستقلّ العقل بتعيّنه عليه؟
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ مفسدة الوقوع في مخالفة الواقع وضرر تركه - لو كان هو الواقع - أشدّ من مفسدة الوقوع في ترك الآخر، والعقل في مثل ذلك يختار ما إن كان هو الواقع يدفع به الضرر الأشدّ، مثاله: إن كان الواجب هو الواقع تكون كفّارة تركه صيام شهرين، وإن كان الحرام هو الواقع تكون كفّارة فعله صيام شهرٍ واحدٍ.
وبالجملة: فالعقل مستقلٌّ باختيار ذي المرجّح وإن لم يحصل مثل باب دوران الأمر
ص: 77
بين التعيين والتخيير المتيقّن بالامتثال. فالمقام وإن لم يكن من مصاديق الدوران المذكور إلّا أنّه مثله من جهة وقوع الشكّ في الجزم بالمعذورية، فإنّه إن أتى بذي المرجّح يحصل له الجزم بالمعذورية، وإن أتى بغيره لا يحصل له هذا الجزم.
ثم لا يخفى عليك: أنّ ما ذكرنا يجري فيما إذا كان الترجيح أو احتماله في جانب المحتمل، أمّا إذا كان في جانب الاحتمال كأن يكون أحد الحكمين مظنوناً بالظنّ غير المعتبر دون الآخر، فلا ريب في أنّ العقل مستقلٌّ بالأخذ بالمظنون.
ص: 78
لو شكّ في المکلّف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب والتحريم، فتارةً: يكون لتردّده بين المتباينين. واُخرى: لتردّده بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين. فالكلام يقع في مقامين.
وقبل الورود في الكلام عنهما ينبغي بيان ما هو المراد منهما حتى لا يعرض الشكّ في موردٍ أنّه من أيّهما.
فنقول: المراد بالمتباينين: شيئان بينهما بينونة تمنع عن انطباق عنوان کلّ واحدٍ منهما على الآخر، مثل: صلاة الظهر وصلاة العصر، ومثل: الصوم والصلاة، ومثل: الحجّ والزكاة، سواءٌ كان هذا الاقتران بينهما بالذات أو ببعض الخصوصيات.
وأمّا الأقلّ والأكثر فهما: ما يكون الأكثر حاوياً للأقلّ على نحو كان الأكثر هو الأقلّ مع شيءٍ زائدٍ من دون أن يكون الزائد مانعاً عن انطباق عنوان المأمور به على الأقلّ، فإن كان المأمور به هو الأقلّ وأتى بالزائد معه لا يبطل به. إذا عرفت ذلك فنبدأ ببسط الكلام في مقامين.
ص: 79
إعلم: أنّه إذا تعلّق العلم بالوجوب أو الحرمة وتردّد متعلّقه بين شيئين أو أشياء، فإمّا أن نعلم بكونه منجّزاً من جميع الجهات، حتى مع تردّده بين شيئين أو أشياء كثيرة، بحيث كانت المصلحة الكامنة في متعلّقه - الداعية للأمر به والبعث نحوه - تامّةً مطلقةً ولا يرضى المولى بتركه مطلقاً، أو كانت المفسدة الّتي فيه كذلك ولا يرضى المولى بفعله مطلقاً وإن تردّد بين أطراف كثيرة، فلا محيص عن الاحتياط والإتيان بجميع الأطراف في الصورة الاُولى، وترك جميع الأطراف في الصورة الثانية. فإن ترك الموافقة القطعية في الصورة الاُولى وأتى ببعض الأطراف وترك البعض ووقع في مخالفة المولى، يكون عاصياً ولا يكون معذوراً. وكذا في الصورة الثانية إن ترك بعض الأطراف وأتى ببعض آخر ووقع في ارتكاب الحرام.
فلا مجال لإجراء البراءة والتمسّك بعموم ما دلّ على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة في أطراف العلم لمناقضتها مع العلم المذكور، ولمناقضة الترخيص في الفعل مع التحريم الفعلي، والترخيص في الترك مع الإيجاب الفعلي. ولا فرق فيما ذكر بين كون الشبهة محصورة وغيرها.
وإمّا أن نعلم بعدم كون التكليف فعلياً بهذه المثابة؛ فلا مانع - على ما أفاده في الكفاية((1)) - عقلاً ولا شرعاً عن شمول أدلّة البراءة للأطراف. بل لا حاجة للتمسّك
ص: 80
بها لعدم موقعٍ لجريان البراءة - الّتي مجراها التكليف المشكوك - في هذا الفرض الّذي نقطع بعدم التكليف.
نعم، لو شككنا في كون التكليف من أيّهما، يتعيّن الرجوع إلى البراءة هنا إذا كان التكليف محرزاً بالقطع، هذا.
وأمّا إذا كان المحرِز للتكليف حجّة شرعيّة، كما إذا قامت الأمارة على حرمة الخمر وشككنا في أنّ حرمته فعليةٌ مطلقاً ولا يرضى المولى بشربه وإن تردّد بين مائعين وأكثر، فلابدّ من ملاحظة الدليل الدالّ على حرمة الخمر، وأنّه هل يكون دالّا على تحريمه مطلقاً وإن تردّد بين مائعين أو لا؟ وعلى فرض الإطلاق لابدّ من ملاحظة معارضه إن وجد له معارضٌ، وعلاج التعارض بينهما إن أمكن. وإلّا فإذا لم يكن للدليل إطلاق، أو كان ولكن صار معارضاً بدليلٍ آخر ولم يمكن علاج التعارض الواقع بينهما تجري البراءة العقلية. وأمّا النقلية فما كان منها ناظراً إلى الشبهة الموضوعية مثل: «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه»((1)) فيجري، سيّما إذا كان الشكّ في الإطلاق، بل مع إطلاق دليل الحرمة أيضاً يجري مثله، لحكومة مثل: «كلّ شيءٍ...» على إطلاق دليل التحريم، دون ما إذا كان مثل حديث الرفع الناظر إلى الشبهة الحكمية.
ص: 81
لا ريب في أنّ الاضطرار إلى ترك واجبٍ معيّنٍ أو فعل حرامٍ معيّنٍ موجبٌ لجواز الترك في الأوّل وجواز الارتكاب في الثاني. وأمّا إذا اضطرّ إلى ارتكاب بعض الأطراف فيما علم حرمته إجمالاً، أو ترك بعض الأطراف فيما علم وجوبه إجمالاً، فلا ريب في الحكم وجواز العمل على مقتضى الاضطرار في نفس المضطرّ إليه إذا كان معيّناً، أو ما يختاره من الأطراف إذا كان الاضطرار إلى أحدها لا على التعيين. وفي غيرهما من الأطراف يجوز ارتكابه لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي في المضطرّ إليه معيّناً أو اختياراً والشكّ البدويّ في سائر الأطراف، لأنّه لا يبقى للمكلّف بعد الاضطرار إلى بعض الأطراف علم بالتكليف الفعلي في غيره. هذا، إذا كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي بالتكليف وكان مسبوقاً به. وأمّا إذا كان الاضطرار سابقاً على العلم الإجمالي أو مقارناً له فاحتمال كون المعلوم بالإجمال هو المضطرّ إليه يكون مانعاً من العلم الإجمالي بالتكليف، فلا حكم للعقل بوجوب الاحتياط ولزوم تحصيل القطع بالبراءة اليقينية، لعدم العلم بالاشتغال اليقيني.
هذا مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: إنّه إذا اضطرّ إلى غير معيّنٍ من الأطراف، فالحكم بوجوب الاحتياط وتنجّز الواقع يستلزم التناقض؛ فإنّ الزجر الفعلي مثلاً عن
ص: 82
الخمر المردّد بين مائعين يناقض الترخيص الفعلي لارتكاب أحدهما تخييراً لإمكان مصادفة ما يختاره الحرام الواقعي.
فإن قلت: فما الفارق بين المقام وبين ما إذا فقد أحد الأطراف بعد العلم الإجمالي مع أنّ الحكم هناك هو الاحتياط ووجوب الاجتناب عن الباقي؟
قلت: الفرق بين هنا وهناك أنّ عدم الاضطرار إلى مخالفة التكليف من حدود التكليف وقيوده، فهو إنّما يكون مكلّفاً إذا لم يكن مضطرّاً إلى مخالفة التكليف من أوّل الأمر، وإلّا لا يتوجّه إليه التكليف من أوّل الأمر. بخلاف فقد المکلّف به، فإنّ عدمه ليس من قيود التكليف حتى ينتفي بانتفائه، بل ينتفي بانتفاء موضوعه.((1))
هذا، ولكن الشيخ(قدس سره) قد فصّل وقال - فيما إذا كان الاضطرار بعد العلم - : «الظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر؛ لأنّ الإذن في ترك بعض المقدّمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات،((2)) انتهى.
ومراده من ذلك: أنّ الاضطرار قبل العلم يكون مانعاً من حصول العلم الإجمالي بالتكليف، بخلاف ما إذا كان بعد العلم فإنّ التكليف بوجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي صار منجّزاً بالعلم به السابق على حدوث الاضطرار، ومقتضى الجمع بينه وبين الترخيص في المضطرّ إليه، جواز ارتكابه ولزوم الاجتناب عن الباقي.
وفيه: أنّه كما يكون الاضطرار السابق على العلم مانعاً عن تنجّز الحكم الواقعي باعتبار احتمال كون متعلّقه هو ما اضطرّ إليه، يكون مانعا عن بقاء تنجّزه إذا كان
ص: 83
مسبوقاً بالعلم، لعدم بقاء العلم - الّذي كان موجباً لتنجّز التكليف المردّد في البين - بعروض الاضطرار واحتمال كونه هو المضطرّ إليه.
وأفاد السيّد الاُستاذ(قدس سره) في توجيه کلام الشيخ كما قرّره المقرّر الفاضل: «إنّ الحكم الواقعي المفروض تنجّزه بالعلم، سابقٌ على عروض الاضطرار مردّد بين أن يكون متعلّقاً بهذا الفرد القصير عمره وبين أن يكون متعلّقاً بالفرد الّذي يكون عمره طويلاً، فإن كان بحسب الواقع متعلّقاً بالفرد القصير يكون تنجّزه إلى هذا الحدّ، وإن كان متعلّقاً بالفرد الطويل يكون تنجّزه للتالي، فكلّ من الفردين - بقصر أحدهما وطول الآخر - يكون طرفاً للعلم الإجمالي الّذي يكون منجّزاً للحكم المردّد، وخروج هذا الفرد ببعض أزمنة وجوده عن متعلّق الحكم لا يوجب خروجه عنه مطلقاً بجميع أزمنة وجوده حتى يكون الحكم باعتبار احتمال التصادف مشكوكاً وغير منجّز.
والحاصل: أنّ هذا الفرد قبل عروض الاضطرار يكون طرفاً لفردٍ لا يكون معروضاً للاضطرار ويجب الاحتياط بحكم العقل في کليهما بحسب القصر والطول».((1)) انتهى.
هذا، وجاء في هامش الكفاية: أنّ الاضطرار لو كان إلى أحدهما المعين، فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجّز، لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم إجمالاً المردّد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو المطلق في الطرف الآخر، ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلوم أصلاً، وعروض الاضطرار إنّما يمنع عن فعلية التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه، لا عن فعلية المعلوم بالإجمال المردّد بين التكليف المحدود في طرف المعروض والمطلق في الآخر بعد العروض. وهذا
ص: 84
بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فإنّه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقاً، فافهم وتأمّل.((1))
وخلاصة ما أفاد: أنّ المعلوم بالإجمال في التكليف المردّد بين ما يعرضه الاضطرار وما هو المطلق يكون في الطرف الّذي يعرضه الاضطرار محدوداً به. فهو مكلّفٌ إمّا بما هو محدودٌ بعروض الاضطرار، أو بما هو مطلقٌ عن ذلك. وذلك - أي كونه محدوداً به - لا يوجب عدم تنجز التكليف به، كالتكليف المردّد بين القصير والطويل؛ فإنّ تردّد التكليف بين حرمة فعلٍ من يوم السبت إلى يوم الأحد؛ وحرمة فعل آخر من يوم السبت إلى الخميس مثلاً، لا يوجب عدم تنجّزه بالعلم به.
وإذا كان أحد المعيّن من طرفي المعلوم بالإجمال المعيّن معروضاً للاضطرار، كما إذا علم بكون أحد المائعين خمراً ثم اضطرّ إلى ارتكاب أحدهما المعيّن، فحرمة ذلك المعيّن إن كان هو المکلّف به محدودةٌ إلى زمان عروض الاضطرار إليه، فهو مكلّفٌ بالاحتياط والاجتناب عنه إلى زمان عروض الاضطرار، كما هو مكلّفٌ بالاجتناب عن الآخر مطلقاً.
ولكن يمكن أن يقال: إنّ التكليف في الجانب الّذي يعرضه الاضطرار إذا كان منحلّا بتكاليف عديدة كحرمة شرب الخمر، لا ينحلّ العلم الإجمالي به بعروض الاضطرار لأحد جانبي العلم في بعض أفراده. وأمّا إذا كان العلم الإجمالي تعلّق بكون أحد المائعين خمراً ثم اضطرّ إلى ارتكاب أحدهما المعيّن فلا ريب في أنّ الاضطرار إليه رافع للتكليف بالاجتناب عنه، فينحلّ به العلم الإجمالي بالتكليف بينهما بجواز المضطرّ إليه والشكّ البدويّ في حرمة الآخر.
ص: 85
ويمكن دفع ذلك: بأنّ هذا إنّما يتمّ لو علم بعد العلم الإجمالي - بكون أحدهما خمراً - أنّ أحدهما المعيّن المضطرّ إليه من أوّل الأمر: وأمّا إذا عرض الاضطرار إليه بعد العلم فيكون الحكم بوجوب الاجتناب محدوداً بعروض الاضطرار، وفي مثله لا ينحلّ العلم الإجمالي بحدوث الاضطرار.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ المکلّف به هنا ليس إلّا الاجتناب عن المائع المعيّن، فإذا صار المکلّف مضطرّاً إليه يرتفع التكليف بالاجتناب عنه. ويكشف عروض الاضطرار عن كون التكليف بالاجتناب عنه مرفوعاً وإن كان يجب عليه الاجتناب ظاهراً مادام لم يعرض الاضطرار.
وبعبارة اُخرى نقول: إنّ الحرام إذا كان مردّداً بين شيئين يحتاج تحقّق الاجتناب عنه - لو كان في کلّ منهما - إلى زمان أزيد من الزمان الذي يتحقّق العصيان فيه، بحيث يمكن تحقّق عصيانه في هذا الزمان وفي هذا وهذا، ولكنّ الامتثال والاجتناب عنه لا يتحقّق إلّا بتركه في جميع هذه الأزمنة، فإذا اضطرّ المکلّف إلى إتيانه في بعض هذه الأزمنة يسقط التكليف به أي بالمردّد بينهما، في الطرف المضطرّ إليه لأجل الاضطرار، وفي الطرف الآخر لسقوط العلم الإجمالي عن تنجّز التكليف به، لاحتمال كون المضطرّ إليه هو المکلّف به، والشكّ في كونه هو الآخر. فأين هذا من دوران الأمر بين المحدود والمطلق، والقصير والطويل؟! فتأمل.
لا ريب في أنّ النهي عن شيءٍ إنّما يصحّ إذا كان ذلك محلّ ابتلاء المكلّف؛ لأنّ فائدة النهي الزجر عن المنهيّ عنه فإذا لم يكن محلّ الابتلاء، لا يتحقّق الزجر والانزجار ولا النهي والانتهاء. ففي العلم الإجمالي بحرمة أحد شيئين أو أشياء إذا كان بعض
ص: 86
الأطراف خارجاً عن الابتلاء لا يتنجّز به التكليف المعلوم بالإجمال، لاحتمال كونه في غير محلّ الابتلاء، فيقع الشكّ الابتدائي في حرمة غيره.
وبعبارةٍ اُخرى: يصير الشكّ الواقع فيه من الشكّ في التكليف لا المكلّف به.
وهكذا إذا شككنا في كون بعض الأفراد في العلم التفصيلي بالمكلّف به، أو بعض الأطراف في العلم الإجمالي محلّ الابتلاء أو خارجاً عنه، ففيه أيضاً يرجع الشكّ في الصورة الاُولى إلى الشكّ في التكليف في خصوص الفرد المشكوك كونه محلّ الابتلاء، وفي الصورة الثانية أيضاً يرجع إلى الشكّ في التكليف؛ لأنّه إذا كان الحرام في الجانب المشكوك كونه محلّ الابتلاء لا تتنجّز حرمته، لاحتمال كونه خارجاً عن محلّ الابتلاء و عدم تعلّق النهي به، فهو على فرض كونه واقعاً تحت النهي إذا شكّ في كونه محلّ الابتلاء يكون تعلّق النهي به مشكوكاً، فلا يكون العلم الإجمالي بتعلّق النهي به أو بغيره المعيّن موجباً لتنجّز النهي عنه إن كان متعلّقاً به، وفي الطرف الآخر أيضاً يكون الشكّ فيه بدويّاً.
هذا، ولكن الشيخ الأنصاري(قدس سره) قال: إذا شكّ في قبح التنجيز [أي كونه خارجاً عن محلّ الابتلاء أو داخلاً فيه] فيرجع إلى الإطلاقات. فمرجع المسألة إلى أنّ المطلق المقيّد بقيدٍ مشكوك التحقّق في بعض الموارد لتعذّر ضبط مفهومه على وجهٍ لا يخفى، مصداقٌ من مصاديقه، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية، هل يجوز التمسّك به أو لا؟ والأقوى الجواز، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب إلّا ما علم عدم تنجّز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام.
إلّا أن يقال: إنّ المستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة((1)) كون الماء وظاهر
ص: 87
الإناء من قبيل عدم تنجّز التكليف، فيكون ذلك ضابطاً في الابتلاء وعدمه إذ يبعد حملها على خروج ذلك من قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النصّ، فافهم.((1))
هذا، وأفاد السيّد الاُستاذ في وجه ما ذكره الشيخ قدّس سرّهما: أنّ ما ذكره هنا مبنيٌّ على ما ذكره في المطلق والمقيّد من أنّ عنوان المقيّد إذا كان مبهماً موجباً الشكّ في بعض مصاديقه يقيّد المطلق بما هو القدر المتيقّن للمقيّد فيتمسّك في غيره بظهور المطلق في الإطلاق. والمقام من هذا، لأنّ إطلاق الخطاب يشمل کلّ فردٍ من أفراد العنوان المأخوذ في موضوع الخطاب وما لا يكون من أفراده محلّ الابتلاء يخرج عنه بدليلٍ لبيّ وهو عدم شمول الخطاب ما هو خارجٌ عن محلّ الابتلاء، وهذا عنوانٌ مبهمٌ يقتصر في الخروج عن تحت العنوان الّذي هو موضوع الخطاب بما هو المتيقّن خروجه عنه.((2))
وأجاب السيّد الاُستاذ عنه: بأنّ صحّة التمسّك بالإطلاق تتوقّف على صحّة الإطلاق وجواز الزجر والنهي وعدم كونه لغواً ومن تحصيل الحاصل، وإذا كان ذلك مشكوكاً فيه لا يجوز الحكم بشمول الإطلاق.
وبعبارةٍ اُخرى: إطلاق الحكم يشمل من أفراده ما كان داخلاً في محلّ الابتلاء دون ما كان خارجاً عنه أو شكّ في كونه داخلاً فيه، فمقتضى الأصل عدم حرمته. هذا مضافاً إلى أنّ التقييد العقلي يكون بمنزلة التقييد اللفظي المتّصل، يسرى إبهامه إلى المطلق ويمنع من استقرار ظهوره في مقام الشكّ، والله هو العالم.((3))
ص: 88
لا ريب في أنّه مع العلم بفعلية التكليف من جميع الجهات، سواءٌ كان متعلّقه مردّداً بين اُمورٍ محصورةٍ أم غير محصورةٍ، يجب الاحتياط بالاجتناب عن جميع الأطراف أو الإتيان بجميعها. هذا إذا كان متعلّق العلم نفس التكليف.
ولا يستدرك ذلك بما إذا كانت كثرة الأطراف في موردٍ موجبةً لعسر موافقته القطعية باجتناب کلّها أو ارتكابه، كما هو ظاهر کلام الكفاية.((1))
لأنّ الأمر لا يخلو من صورتين: فإمّا يكون التكليف مشكوكاً لا يعلم بعث الشارع نحو الفعل أو زجره عنه، فلا علم بفعليته مطلقاً؛ وإمّا أن تكون فعلية التكليف مطلقاً معلومةً،
فلا وجه للاستدراك والاستثناء.
ولكن يمكن أن يقال: إنّ مفروض کلامهم في المقام هو العلم بما هو حجّة على التكليف لا العلم بنفس التكليف، كما هو ظاهر عباراتهم. وإذا كان مرادهم ذلك، أي العلم بالحجّة الّتي تقوم على الحكم وتدلّ بإطلاقها على الوجوب أو الحرمة وإن كانت أطراف الشبهة كثيرة، فيمكن أن يقال: إذا كانت هذه موجبة لعسر الموافقة القطعية والاحتياط التامّ لا يكون التكليف معها فعلياً. وذلك لا يوجب تناقضاً، لأنّ من الممكن العلم بحجّةٍ تدلّ بإطلاقها على التكليف مطلقاً، وتقييد إطلاقها بحجّةٍ اُخرى، لأنّ العلم بالحجّة بإطلاقها أو عمومها لا يمنع من تقييدها أو تخصيصها بحجّةٍ اُخرى. فإذا ثبت العسر في موافقة التكليف الّذي دلّت عليه الحجّة، سواءٌ كانت الدلالة عليه بالإجمال أو التفصيل، ترفع اليد عن إطلاقها بالحجّة الأقوى، وهي هنا وقوع المکلّف في العسر بالاجتناب عن جميع الأطراف. هذا إذا اُحرز أنّ كثرة الأطراف موجبةٌ للعسر.
ص: 89
وأمّا إذا شكّ في أنّ كثرة الأطراف وصلت إلى حدٍّ توجب العسر أم لا، فالمرجع إطلاق دليل الحكم؛ لأنّ ظهور المطلق بعد انعقاده حجّةٌ ومتّبعٌ لا يجوز التخلّف عنه إلّا بمقدارٍ قام الدليل الأقوى على خروجه عن تحت الإطلاق. فإنّ إطلاق دليل الأحكام الواقعية يقتضي ثبوت الحكم لموضوعه مطلقاً ولو مع الجهل وعروض بعض العوارض والطوارئ كالعسر والحرج، إلّا إذا قام الدليل الأقوى من النصّ أو الإجماع أو السيرة القطعية على عدم تنجّز الحكم عند طروّ بعض الطوارئ، كاشتباه موضوعه بين أطراف غير محصورةٍ بحيث يستلزم تنجّزه العسر على المکلّف. فيقتصر في رفع اليد عن إطلاق الدليل بمقدارٍ دلّ الدليل الأقوى على خروجه عن الإطلاق، دون غيره.
إنّما يحكم العقل بوجوب الاحتياط بالاجتناب عن الأطراف في الشبهة التحريمية والإتيان بها في الوجوبية؛ لأنّ اليقين بالامتثال يكون متوقّفاً على تركها أو فعلها، ولا يتعدّى الحكم إلى غيرهما. وإن كان واقعاً محكوماً بحكم أحد الطرفين.
ففيما علم بنجاسة أحد الماءين يكفي في امتثال النهي المتعلّق بشرب النجس في البين ترك شربهما، أمّا الماء الّذي لاقى أحدهما فلا يجب الاجتناب عنه وإن كان هو في الواقع يكون محكوماً بحكم ما لاقاه.
فيجب الاجتناب عن الملاقى - بفتح القاف - الماء الّذي كان طرف العلم الإجمالي، ويجوز ارتكاب الملاقي - بكسر القاف - الماء الثالث. وذلك لحصول القطع باجتناب النجس في البين وامتثال التكليف بالاجتناب عن الطرفين، وأمّا الملاقي - بالكسر - فالشبهة بالنسبة إليه بدويّة، فإنّه لو صار نجساً بالملاقاة يكون التكليف بالاجتناب عنه تكليفاً آخر، لكونه نجساً آخر.
ص: 90
ويستفاد من الكفاية في المسألة:((1)) أنّه إن كان الملاقي - بالكسر - خارجاً عن الأطراف يكون الشكّ بدويّاً لا يوجب الاجتناب عنه، كما لو وقعت الملاقاة بعد العلم الإجمالي بالنجس فلا يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - وذلك لأنّ مقتضى العلم الإجمالي المذكور ليس إلّا الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وطرفه الآخر، دون الملاقي - بالكسر - وإن كان هو محكوماً بحكم الملاقى لو كان هو النجس المعلوم بالإجمال، فالملاقي - بالكسر - في هذه الصورة حيث يكون خارجاً عن الأطراف لا يجب الاجتناب عنه.
وقد يكون الملاقى خارجاً عن الأطراف دون الملاقي - بالكسر - كما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الثوبين ولاقى أحدهما المعيّن مع ما يقع طرفاً بعد ذلك للعلم الإجمالي بنجاسته أو بعض أطراف العلم الأوّل؛ فإنّ الملاقى - بالفتح - وإن كان طرفاً للعلم الثاني إلّا أنّه لا يكون تعلّق العلم الإجمالي الثاني به منجّزاً لوجوب الاجتناب عنه إن كان نجساً واقعاً، وذلك لأنّ طرفه من أطراف العلم الإجمالي الأوّل المنجّز به. وعلى هذا، يكون الملاقي - بالكسر - واجب الاجتناب دون الملاقى - بالفتح - لعدم كونه طرفاً للعلم الإجمالي المنجّز.
وكما إذا حصلت الملاقاة أوّلاً كأن لاقى شيءٌ أحد المائعين وصارا متعلّقين للعلم الإجمالي بنجسٍ بينهما وخرج الملاقي - بالكسر - حال حدوث العلم عن مورد الابتلاء، ففي حال حدوثه يكون الملاقى - بالفتح - واجب الاجتناب دون الملاقي، فإن صار مبتلىً به بعده يكون الشكّ في وجوب الاجتناب عنه من الشكّ البدويّ، كما أنّه إذا لم يخرج الملاقي - بالكسر - عن محلّ الابتلاء يكون هو والملاقى طرفاً واحداً للطرف الآخر، وهذه الصورة هي الصورة الثالثة المذكورة في الكفاية.
ص: 91
هذا، ولكن السيّد الاُستاذ أورد على اُستاذه(قدس سره): بأنّ الحكم بعدم لزوم الاجتناب في المقام ليس مبتنياً على ما أفاد، أي خروج الملاقي عن الأطراف، بل الحقّ في المقام ما حقّقه الشيخ(قدس سره)((1)) من عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي مطلقاً من غير فرقٍ بين تقدّم العلم على الملاقاة أو تقدّمها عليه؛ فإنّ الأصل المسبّبي في الملاقي - بالكسر - يجري مطلقاً بعد عدم جريان الأصل السببي بالمعارضة في طرفي الشبهة. وهذا ظاهرٌ في صورة تقدّم العلم بالنجاسة على العلم بالملاقاة. وأمّا في صورة تقدّم العلم بالملاقاة على العلم بالنجاسة فإنّه وإن كان يحصل العلم إمّا بنجاسة الملاقي والملاقى أو طرفه إلّا أنّ الأصل الّذي هو في رتبة الأصل الجاري في الطرف هو الأصل الجاري في الملاقى - بالفتح - وهما يسقطان بالتعارض والحكم فيهما الاحتياط بالاجتناب عن کلا الطرفين وفي الملاقي - بالكسر - تجري أصالة الطهارة.
هذا مضافاً إلى أنّه يرد على الكفاية، كما أفاد السيّد الاُستاذ(قدس سره): أنّه بعد حصول العلم بالنجاسة والملاقاة يحصل العلم بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف الآخر، فيكون کلاهما طرفاً للآخر، كما إذا وقعت قطرةٌ من الدم في هذا الإناء المعيّن أو في الإناءين الآخرين، فيحكم العقل بلزوم الاجتناب عن کلّها حتى الملاقي كما يحكم بوجوب الاجتناب عن الإناء المعيّن والإناءين الآخرين في المثال المذكور. نعم، الفرق بين المثال والمقام وجود المؤمّن في المقام وهو الأصل الجاري في الملاقي دون المثال، فتدبّر جيّداً.
هذا، وأمّا الاستدلال بلزوم الاجتناب عن الملاقي بقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾.((2))
ففيه: أنّ شمول الآية الكريمة لملاقي الرجز المعلوم بالتفصيل ممنوعٌ، فكيف به إذا كان بالعلم الإجمالي! والله وليّ التوفيق.
ص: 92
لا يخفى عليك: أنّ مرادهم في المقام من الأكثر ما هو مشتمل على الأقلّ وحاويه مع شيءٍ زائدٍ عليه، لكن لا تكون زيادته على الأقلّ مانعةً عن صحّة الأقلّ.
وبعبارة اُخرى: الأقلّ: ما لوحظ لا بشرط عمّا يزاد عليه بالإتيان بالأكثر. والأكثر: ما هو مشروطٌ بما كان الأقلّ لا بشرط عنه.
ومعنى الارتباط بينهما: أنّ المأمور به لو كان الأكثر فلابدّ وأن يوتى به، فإن أتى بالأقلّ لم يأت بالمأمور به.
ومن ذلك يعلم: أنّ ذلك في الصلاة لا يكون إلّا في الأجزاء غير الركنية كوجوب السورة. وأمّا فرض الشكّ بين الأقلّ والأكثر في أركان الصلاه، فهو من الشكّ في المتباينين.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أن الشيخ(قدس سره) اختار في المسألة البراءة العقلية.
ودليله على ما اختاره - حسبما ذكره السيّد الاُستاذ قدس سرهما - هو: أنّا نعلم بالتفصيل بتوجّه الأمر - بكلّه أو ببعضه - إلى الأقلّ وإن شكّ في تعلّقه بالزائد، والعلم بتوجّه الأمر به ولو كان ببعضه يكفي في تنجّزه ووجوب امتثاله عند العقل، وحرمة مخالفته بخلاف الزائد، للشكّ في تعلّق الأمر به.
وليس معنى ذلك أنّه علم إجمالاً بوجوب الأقلّ والأكثر ثم انحلّ العلم الإجمالي بالتفصيلي في الأقلّ والشكّ البدوي بالنسبة إلى الأكثر، حتى يرد عليه ما يأتي من
ص: 93
الكفاية. وهذا ما يستفاد من مطاوي کلما ت الشيخ،((1)) إلّا أنّه يستفاد من بعض کلماته أنّ الدليل على البراءة في المقام هو الانحلال المذكور، وهذا ما قاله في آخر کلامه بلفظه:
«وبالجملة: فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثّرٍ في وجوب الاحتياط، لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلاً والآخر مشكوك الإلزام».((2)) ثم قال بعد سطورٍ: «ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلومٍ تفصيليٍّ ومشكوكٍ».((3))
ووجه الانحلال عنده: أنّ الأقلّ واجبٌ مطلقاً إمّا بالوجوب النفسي أو بالوجوب المقدّمي، وأمّا الأكثر فإن كان واجباً فلا يكون إلّا بالوجوب النفسي، فالأقلّ واجبٌ تفصيلاً معلومٌ وجوبه، والأكثر وجوبه مشكوك.
وبعبارة اُخرى: وجوب الأقلّ منجّزٌ يجب على المکلّف امتثاله دون الأكثر؛ فإنّ وجوبه النفسي مشكوك مجهولٌ فلا يجوز العقاب على تركه، لأنّه عقابٌ بلا بيان.
هذا، واختار المحقّق الخراساني في المسألة: لزوم الاحتياط - بالإتيان بالأكثر - عقلاً؛((4)) لأنّ تعلّق التكليف بالأقلّ أو الأكثر يكون نظير المتباينين يجب الخروج عنه تعلّق بالأقلّ أو بالأكثر، إلّا أنّه في المتباينين - المصطلح قبال الأقلّ والأكثر - لا يمكن الاحتياط ولا يخرج المكلّف عن عهدة التكليف المردّد بينهما إلّا بإتيان کلّ منهما مستقلّا، وفي الأقلّ والأكثر الارتباطيين يتحقّق الاحتياط والامتثال بالإتيان بالأكثر ولا يجب عليه أن يأتي بالأقلّ مستقلّا وبالأكثر كذلك.
ص: 94
فالأقلّ والأكثر الارتباطيان قسمٌ من المتباينين لا قسيمهما؛ وذلك لأنّ الملحوظ في کلّ منهما - إن كان هو المأمور به - غير ما هو الملحوظ في الآخر، إن كان هو المأمور به فالملحوظ في الأقلّ - إن كان هو المأمور به - تسعة أجزاء وهو غير الملحوظ في الأكثر وهو عشرة أجزاء - إن كان هو المأمور به - فهما في مقام الجعل متباينان لا يمكن إجراء البراءة عن تعلّق الحكم بأحدهما دون الآخر، فبالعلم الإجمالي نعلم تعلّق الأمر إمّا بالمركّب من تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، فكلٌ منهما طرفٌ للعلم وليس العقاب على ترك کلّ واحدٍ منهما - لو كان هو المأمور به - عقاباً بلا بيان.
نعم، الملحوظ في الأقلّ - إن كان هو المأمور به - وما جعله الآمر تحت أمره لا بشرط عن الزيادة عليه، ولكنّه بما هو ملحوظ عند تعلّق الأمر به غير الأكثر، ولكن في مقام الامتثال يكتفى بالأكثر ويتحقّق الاحتياط بالإتيان به، ولا يجب الإتيان بكلٍّ منهما مستقلّا كغيرهما من المتباينين، فافهم وتدبّر في ذلك حتى لا تتوهّم كما توهّمه البعض أنّ كون النسبة بين الأقلّ والأكثر التباين تقتضي الاتيان بكل منهما مستقلّا.
فما تنبّه إليه بعض المعاصرين فإمّا أن يكون من إفادات المحقّق الخراساني(قدس سره)، أو من إفادات تلميذه العظيم السيّد الاُستاذ(قدس سره) وإن كان الغالب على الظنّ أنّه من المحقّق الخراساني، بل هو مذكورٌ في کلما ت صاحب الحاشية((1)) كما أشار إليه اُستاذنا المحقّق مقرّر بحث الشيخ النائيني في فوائد الاُصول.((2)) شكّر الله مساعي الجميع، وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء، وغفر لنا زلّاتنا، فإنّه الغفور الغفّار.
ثم إنّ المحقّق الخراساني(قدس سره) أجاب عن الانحلال المذكور في کلام الشيخ: بأنّ الانحلال بالعلم التفصيلي بوجوب الأقلّ والشكّ في الأكثر يلزم من وجوده العدم؛
ص: 95
وذلك لأنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ لا يحصل إلّا إذا كان الأكثر واجباً بالوجوب الفعلي، حتى يكون الأقلّ على فرض عدم وجوبه بالوجوب النفسي واجباً بالوجوب التبعي ويكون واجباً على کلّ تقديرٍ، وفرض فعلية وجوب الأكثر لا يجتمع مع الانحلال والشكّ في وجوب الأكثر، ويلزم من فرض الانحلال عدم وجوب الأكثر ومن عدم وجوب الأكثر عدم الانحلال.((1))
هذا، وأفاد السيّد الاُستاذ في وجه عدم وجوب الاحتياط وجواز الاكتفاء بالأقلّ بما هو قريبٌ ممّا قال عنه بأنّه يستفاد من مطاوي كلمات الشيخ(قدس سره) وإن كان ظاهر بعض کلماته الاخرى أنّ الوجه لذلك هو الانحلال.
وكيف كان، فقد أفاد السيّد الاُستاذ(قدس سره): بأنّ المرّكب الاعتباري الجعلي يعتبر باعتبار اُمورٍ وأشياء متشتةٍ شيئاً واحداً تكون تلك الأشياء أجزاءها، فهو كثيرٌ بالكثرة الحقيقية وواحدٌ بالوحدة الاعتبارية، فإذا تعلّق الأمر بهذا المركّب ينبسط على أجزائه بحيث يرى كلّ جزءٍ منه مأموراً به واجب الإتيان به، وتعلّق الأمر بها يكون بعين تعلّقه بالمركّب. فإذا شككنا في وقوع شيءٍ تحت هذا الأمر، أو أنّ المعتبر اعتبره في المركّب يكون الأصل عدم اعتباره جزءاً، كما أنّ الأصل براءة الذمّة عقلاً عن الإتيان به. وبعبارة اُخرى: انبساط الأمر على الأقلّ معلومٌ وعلى الأكثر مشكوك.((2))
ص: 96
لا يقال: إنّ الإتيان بالأقلّ لا يوجب رفع الشكّ بالامتثال به، لأنّه إذا كان الأكثر مأموراً به يكون تحقّق امتثال الأمر بالأقلّ منوطاً بالأكثر لارتباطه به، فيجب الإتيان بالأكثر لتحصيل العلم بامتثال الأمر المتعلّق بالأقلّ.((1))
فإنّه يقال: إذا كان الأمر منبسطاً على الأجزاء يتحقّق بإتيان کلّ جزء منه امتثالُ مقدارٍ من الأمر، وهذا المقدار يكفي في تحقّق الامتثال وكون العبد في مقام الانقياد والإطاعة. ولا دخل لإتيان ما يحتمل دخله في المأمور به في امتثال الأمر. وبعبارة اُخرى: القدر المتيقّن ممّا وقع تحت الأمر هو هذا الجزء المرتبط بسائر الأجزاء المعلومة، ويكفي في امتثال الأمر به الإتيان به.
هذا، وتظهر النتيجة للمباني المذكورة أوّلاً: أنّه إذا أتى بالأقلّ وكان المأمور به بحسب الواقع الأكثر فعلى ما بنى عليه المحقّق الخراساني يكون معاقباً بترك الأكثر، وأمّا على مبنى الشيخ وما بنى عليه السيّد الاُستاذ فهو معذورٌ لا يستحقّ المؤاخذة.
وثانياً: إن لم يأت لا بالأكثر ولا بالأقلّ فهو يستحقّ العقوبة على الأقلّ على القول بعدم وجوب الاحتياط، وعلى الأكثر على القول بوجوب الاحتياط وكون المأمور به في الواقع الأكثر، وإلّا فلا يستحقّ العقوبة إلّا على الأقلّ، والله هو العالم.
هذا کلّه بحسب حكم العقل والبراءة العقلية.
وأمّا الكلام بحسب النقل والبراءة الشرعية، فاعلم: أنّه قد حكي في تقريرات
ص: 97
سيّدنا الاُستاذ((1)) اتّفاقهم على جريان البراءة النقلية في المقام حتى عن مثل المحقّق الخراساني القائل بعدم جريان البراءة العقلية، وإن كان الظاهر منه فيما أفاده في هامش الكتاب العدول عن ذلك، كما يأتي بيانه.
ولا يخفى عليك جريان البراءة الشرعية على مبنى السيّد الاُستاذ وما ربما يستفاد من مطاوي کلما ت الشيخ قدّس سرّهما من انبساط الأمر والوجوب على الأجزاء. فكلٌ منها واقعٌ تحت الأمر ويسقط بإتيانه مقدار منه ويطاع المولى بحسبه، فإذا شكّ في كون جزءٍ زائدٍ على الأجزاء المعلومة تحت الأمر، يرفع وجوبه بمثل حديث الحجب والرفع، ويكفي في الامتثال الإتيان بالأجزاء المعلومة الواقعة تحت الأمر؛ فإنّ العقاب على ترك غيرها عقابٌ بلا بيانٍ. مضافاً إلى أنّ مقتضى وقوع أدلّة البراءة مثل حديث الرفع في طول الأحكام الأوّلية ذلك. فالحديث كما يرفع وجوب الجزء المشكوك يدلّ أيضاً على جواز الاكتفاء بسائر الأجزاء.
وعلى القول - في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين - برجوع ذلك إلى العلم بوجوب الأقلّ نفسياً أو تبعياً أيضاً تجري البراءة عن وجوب الأكثر.
وأمّا من يقول بعدم جريان البراءة العقلية مثل المحقّق الخراساني، فإنّه يقول بأنّ عموم مثل الحديث رافعٌ لجزئية ما شكّ في جزئيته، وأنّ بمثله يرتفع الإجمال والتردّد بين الأقلّ والأكثر ويعيّن به الأقلّ.
والإشكال على ذلك بأنّ المرفوع بحديث الرفع لا يكون إلّا ما هو مجعولٌ بنفسه أو أثره، ووجوب الإعادة ليس من آثار الجزئية بل هو من آثار بقاء الأمر الأوّل بعد العلم به. مضافاً إلى أنّه أثرٌ عقلي من باب وجوب الإطاعة عقلاً.
ص: 98
مدفوعٌ: بأنّ الجزئية وإن لم تكن مجعولة بنفسها إلّا أنّها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها، وهذا يكفي لصحّة رفعها.
لا يقال: الأمر الانتزاعي إنّما يرتفع برفع منشأ انتزاعها وهو هنا الأمر الأوّل الّذي تعلّق بجميع الأجزاء، فإذا رفع هذا الأمر فما هو الأمر الدالّ على وجوب الخالي عن هذا الجزء.
فإنّه يقال: نعم، وإن كان ارتفاع الأمر الانتزاعي يكون بارتفاع منشأ انتزاعه إلّا أنّ نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء نسبة الاستثناء المتّصل بها، ومعه تكون الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء دليلاً على وجوب سائر الأجزاء بالنسبة إلى الجاهل ببعضها.
وبعبارةٍ اُخرى: يستفاد من الأدلّة بعد ضمّ حديث الرفع إليها أنّ صلاة العالم بجميع أجزائها هي المركّبة من جميع الأجزاء، وصلاة الجاهل ببعض الأجزاء هي المركّبة من الأجزاء المعلومة، والجزء المشكوك خارجٌ عنها.
هذا، ولكنّ المحقّق الخراساني كأنّه عدل عن صحّة التمسّك بالبراءة الشرعية في المقام في ما أفاد في وجه ذلك، فقال: «لا يخفى: أنّه لا مجال للنقل في ما هو مورد حكم العقل بالاحتياط، وهو ما إذا علم إجمالاً بالتكليف الفعلي، ضرورة أنّه ينافيه دفع الجزئية المجهولة، وإنّما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك، بل علم مجرّد ثبوته واقعاً. وبالجملة: الشكّ في الجزئية والشرطية وإن كان جامعاً بين الموردين إلّا أنّ مورد حكم العقل مع القطع بالفعلية، ومورد النقل هو مجرّد الخطاب بالإيجاب، فافهم.((1)) انتهى.
وفيه: أنّه على مبنى السيّد الاُستاذ وما يستفاد من مطاوي کلما ت الشيخ قدس سرّهما التكليف بالأقلّ معلومٌ بالتفصيل والأكثر مشكوكٌ فيه. هذا مضافاً إلى أنّ
ص: 99
الانحلال الّذي منعه لا يتوقّف على تنجّز التكليف على تقدير تعلّقه بالأكثر أو الأقلّ، بل هو عبارةٌ عن وجوب ذات الأقلّ مطلقاً وعلى کلّ تقديرٍ وإن لم يكن التكليف على تقدير كونه الأكثر بالنسبة إلى خصوصه منجّزاً، ففي الواقع يحصل العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ إمّا تبعا أو مستقلّا، ولا منافاة بين ذلك وبين عدم تنجّز الأكثر بالخصوص، فتدبّر.
ص: 100
هنا اُمورٌ ينبغي التنبيه عليها:
إنّه قد وقع الاختلاف في الشكّ في شرطية شيءٍ للمأمور به، فاختار الشيخ(قدس سره)((1)) جريان البراءة فيه مطلقاً عقلاً ونقلاً، وسواءٌ كان الشرط منتزعاً عن ذات المشروط باعتبار بعض الحالات الذاتية أو الصفات العارضية، كالإنسانية للحيوان، والإيمان للرقبة؛ أو كان منتزعاً من شيءٍ مغايرٍ للمقيّد، كالصلاة المقيّدة بالطهارة المنتزعة عمّا يوجبها من الوضوء والغسل والتيمّم.
واختار بعضهم عدم جريان البراءة العقلية فيه مطلقاً، كعدم جريان النقلية منها في الأوّل، وجريانها في الثاني، وهو مختار المحقّق الخراساني.((2))
أمّا عدم جريان البراءة العقلية، فإنّ المقام أولى بعدم جريانها فيه من الشكّ في الجزئية؛ لأنّه نظير المتباينين، ولا يمكن أن يكون المطلق أي الصلاة اللا بشرط عن الطهارة أو الحيوان اللا بشرط عن الإنسانية متّصفاً باللزوم والمقدّمية للصلاة المشروطة بالطهارة وللحيوان المقيّد بالإنسانية، فإنّ الأجزاء التحليلية لا تتّصف باللزوم من باب المقدّمة، فالصلاة المتضمّنة للطهارة المشروطة بها هي عين وجودها لا
ص: 101
مقدّمتها، وكذلك الحيوان المقيّد بوجوده للإنسان، أو الرقبة المقيّدة بقيد الإيمان هو عين وجود الحيوان وعين وجود الرقبة.
وبالجملة: لا تجري في المقام البراءة العقلية.
وأمّا النقلية، فتجري في خصوص ما كان قيد المأمور به منتزعاً عن أمرٍ خارجٍ عنه، كالطهارة المنتزعة من أسبابها، فيقال مثلاً: إنّ شرطية الطهارة - الّتي تنتزع من الوضوء - ممّا لا يعلم، فهي مرفوعة برفع منشأ انتزاعها. بل يمكن رفعها أوّلاً، وبه يرفع وجوب منشأ انتزاعها.
وكيف كان، فقد عرفت في ما حكينا قبل ذلك عن هامش الكفاية أنّ المحقّق الخراساني عدل عمّا أفاد في متن الكتاب من جريان البراءة النقلية في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء، وقال: لا مجال للنقل في ما هو مورد لحكم العقل بالاحتياط... إلخ.((1))
هذا، ولا يخفى عليك: أنّ ما ذكره المحقّق الخراساني في وجه عدم جريان البراءة العقلية((2)) إنّما يرد على الشيخ لو كان مبناه في جريانها انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي، وأمّا إذا كان دليله هناك ما أشرنا إليه - في الشكّ في الجزئية - من أنّ وجوب الأقلّ بالوجوب الضمني الانبساطي الشامل لجميع الأجزاء معلومٌ تفصيلاً والزائد عليه مشكوكٌ مرفوعٌ بالأصل، فهنا يجري هذا الدليل أيضاً، فيقال: إنّ العقل كما هو هناك حاكمٌ بقبح العقاب على ترك الجزء المشكوك، لعدم تنجّز الأمر به لعدم تعلّق العلم به وحاكم بتنجّز الأقلّ؛ فهنا أيضاً هو حاكمٌ بقبح العقاب على ترك الخصوصية والقيد المشكوك اعتباره في المأمور به بعد إتيانه بما هو فاقد لتلك الخصوصية. وهذه
ص: 102
الخصوصية وإن كانت تنتزع عن الذات وهي عينها - وليست كالجزء المشكوك الّتي هي غير سائر الأجزاء حقيقةً - إلّا أنّ العقل يرى تقييد المأمور به بهذا الأمر الانتزاعي وملاحظته كذلك مساوقٌ لملاحظته غيره، فهو بهذا اللحاظ يكون مأموراً به ويقع الشكّ في كونه مأموراً به وتقييد المأموربه به؛ فلهذا تجري بالنسبة إليه قاعدة العقاب بلا بيان إن لم يعلم به، ويصحّ العقاب على إتيان المقيّد (بالفتح) به فاقداً له.
وبناءً على ذلك إذا تعلّق الأمر بمطلقٍ وشكّ في تقييده بأمرٍ، سواءٌ كان التقيد منتزعاً عن نفس الذات أو عن أمرٍ خارجٍ عن الذات، فالعقل مستقلٌّ بلزوم الإتيان بالمطلق وعدم جواز تركه رأساً، كما هو مستقلّ بعدم جواز العقاب على ترك الإتيان به في ضمن الخاصّ. وهذا ما يستفاد من کلام الشيخ(قدس سره)، فراجع وتأمّل في کلامه زيد في علوّ مقامه. وعلى هذا المبنى تجري في نفي وجوب القيد المشكوك البراءة العقلية كالنقلية، والله هو الموفّق للصواب.
إذا شكّ في جزء أو شرط أنّه هل هو جزء أو شرط للمأمور به في حال نسيانه هذه الجزء أو الشرط أم هو مختصّ بحال كونه ذاكراً له؟
وبعبارة اُخرى: هل هو مثل ما إذا شكّ في أصل جزئية شيء أو شرطيته؟ فيقال فيه ما ذكرناه من الأقوال فيه من البراءة العقلية والشرعية عنه، لانحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر في حال النسيان بالعلم التفصيلي بوجوب الأقلّ؛ أو يقال بعدم جريان البراءة العقلية ووجوب الاحتياط بالإعادة، وجريان البراءة النقلية، بل وعدمها أيضاً، لعدم انحلال العلم المذكور؛ أو يقال بوقوع کلّ جزء من الأجزاء تحت الوجوب المنبسط على جميع الأجزاء، فيكون الشكّ في الجزء المنسيّ من الشكّ البدويّ، والأقلّ واجباً بالوجوب الضمني، وقد مرّ تفصيل ذلك کلّه.
ص: 103
ولكنّ الظاهر أنّ کلّ ما ذكر مبنيّ على إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي، فالانحلال المذكور متوقّف عليه، وأصل دوران التكليف بين الجزء المنسيّ وسائر الأجزاء أيضاً يتوقّف على إمكان خطابه والتفات الناسي إلى نسيانه.
ومن الواضح أنّ خطاب الناسي بهذا العنوان يلزم منه عدمه وانقلابه إلى عنوان الذاكر. ومن جانب آخر المركّب الخالي من هذا الجزء الّذي هو المأمور به للناسي أيضاً لا يمكن تعلّق الخطاب به؛ لأنّه أيضاً يلزم من وجوده عدمه، لأنّه حين عدم التفاته وغفلته لا يمكن توجيه الخطاب نحوه بمثل: «يا أيّها الغافل» و«يا أيّها الناسي»، ولو التفت بهذا الخطاب يخرج عن غفلته ونسيانه ويدخل في الذاكرين.
فعلى هذا، لا يدخل المقام في بحث البراءة والاحتياط، وليس البحث عنه كالبحث في أصل الشكّ في الجزئية والشرطية والأقلّ والأكثر. فالمركّب الخالي من الجزء المنسيّ الّذي يأتي به الناسي ليس المأمور به أصلاً؛ وإن دلّ دليل على صحّته لابدّ وأن يحمل على وقوعه بدلاً منه.
وبالجملة: فتصوير كون الفاقد للمنسيّ مأموراً به والناسي مخاطباً به في غاية الإشكال؛ لأنّ توجيه الخطاب نحو الناسي بهذا العنوان يكون لغواً لا يوجب التفاته إلى الخطاب وبعثه به نحو الفعل لغفلته عن نسيانه، وعلى فرض التفاته إلى نسيانه يخرج عن كونه ناسياً ومخاطباً لخطابه بعنوان الناسي.
وقد قيل للتفصّي عن هذا الإشكال وجوه يأتي الإشارة إليها:((1))
ص: 104
فمنها: أن يقال بإمكان أخذ الناسي عنواناً للمكلّف وتكليفه بما عدا الجزء المنسيّ والناسي وإن يمنعه النسيان من الالتفات إلى ذلك الخطاب لعدم التفاته إلى نسيانه، ولا يمكنه امتثال الأمر المتوجّه إليه بهذا الخطاب لكن امتثال الأمر لا يتوقف على أن يكون المکلّف ملتفتاً إليه بخصوصه والعنوان الّذي خوطب به، بل يكفي في ذلك الإتيان بالفعل المأمور به بأيّ عنوان توهّم كونه مخاطباً به من باب الخطأ في التطبيق، فهو في الواقع قصد الأمر المتوجّه إلى ما عدا الجزء المنسيّ الّذي توهّمه بعنوان لا ينطبق عليه، وهو في الواقع معنون بعنوان خوطب هو به.
واُجيب عن ذلك بأنّ فائدة الأمر البعث والتحريك به نحو الفعل ومثل هذا لا يكون سبباً للانبعاث والتحريك ولا يكون أمراً حقيقة.
ومنها: أن يقال: يمكن أن يكون أمر الناسي بما عدا الجزء المنسيّ بعنوان آخر يلازم نسيان الجزء الخاصّ. وقد مثّل له البعض بأن يكون بلغميّ المزاج دائماً ينسي السورة، فيخاطبه بهذا العنوان في الأمر بما عدا الجزء المنسيّ.
ولا يخفى: أنّ ذلك مجرّد الفرض لا يوجد عنوان كان ملازماً لنسيان الجزء من السورة والذكر وسائر الأجزاء غير الركنية.
ومنها: ما نذكره بلفظ اُستاذنا المحقّق الكاظمي(قدس سره) في ما كتبه تقريراً لأبحاث اُستاذه، فقال: «الوجه الثالث: هو ما أفاده المحقّق الخراساني((1)) وارتضاه شيخنا الاُستاذ، وحاصله: أنّه يمكن أن يكون المکلّف به في الواقع أوّلاً في حقّ الذاكر والناسي هو خصوص بقية الأجزاء ما عدا الجزء المنسيّ، ثم يختصّ الذاكر بتكليف يخصّه بالنسبة إلى الجزء الذاكر له ويكون المکلّف به في حقّه هو العمل المشتمل على
ص: 105
الجزء الزائد المتذكّر له، ولا محذور في تخصيص الذاكر بخطاب يخصّه، وإنّما المحذور كان في تخصيص الناسي بخطاب يخصّه...» إلى آخر کلامه،((1)) فراجع إن شئت.
هذا، وأمّا السيّد الاُستاذ(قدس سره) فقد حكى عنه المقرّر الفاضل ونسبه إليه، وقال: إنّه ما أفاده السيّد الاُستاذ وخطر ببالي القاصر، وهو: أنّ الصلاة الّتي اُمر بها جميع المکلّفين على اختلاف أصنافهم - من الحاضر والمسافر، والعاجز والقادر، والذاكر والناسي، وفاقد الماء وواجده، والطاهر من الخبث، وواجد الساتر، وغير هؤلاء، لها أفراد مختلفة بحسب هذه الحالات ينطبق على الجميع عنوان الصلاة الّتي هي المأمور بها، ولا يحتاج کلّ فرد منها إلى أمر خاصّ به حتى لا يمكن توجيه خطاب خاصٍّ إلى الناسي، ولا يلزم أن يكون الناسي الّذي ما يأتي به من الأجزاء عدا الجزء المنسيّ ملتفتاً إلى نسيانه وأنّ هذه الأجزاء إنّما تكون منطبقاً لعنوان الصلاة وفرداً لها لنسيانها الجزء الخاصّ، بل يكفي كونها في هذا الحال فرداً للصلاة ومصداقاً له.
وهذا کلّه بحسب مقام الثبوت، وكون البحث في المقام أيضاً البحث عن البراءة والاحتياط. وعلى هذا، إن دلّ الدليل في مقام الإثبات على عدم جزئية المنسيّ حال النسيان مثل «حديث الرفع»((2)) مطلقاً، و«لا تعاد»((3)) في الصلاة يحكم بالامتثال وعدم وجوب الإعادة، والبراءة عن الجزء المنسيّ.
وبالجملة: يقال فيه ما قلنا في الشكّ في أصل الجزئية والشرطية. والله هو العالم.
ص: 106
إعلم: أنّ زيادة الجزء بما أنّه جزء لا يضرّ بالمركّب؛ لأنّ الجزء ما له دخل في تحقّق المركّب، سواء حصل في ضمن وجود أو وجودين أو أكثر، فالمركّب يتحقّق بوجود طبيعة الجزء وإن كثرت أفراده، فالزائد على الفرد الأوّل يكون لغواً لا مبطلاً وقاطعاً ولا مانعاً.
فالشكّ في زيادة الجزء كاليقين بها لا حكم له.
نعم، إذا كان الشكّ - في زيادة الجزء - راجعاً إلى الشكّ في كونها مانعة أم لا؟ يجري فيه حكم الشكّ في الجزء والشرط، فالأصل البراءة العقلية والنقلية منه، بناءً على أنّ المانع ما اعتبر مفسداً للعمل بعد تماميته وصحّته كما قد يستظهر من أدلّته، وبناءً على كون المانع ما اعتبر عدمه شرطاً للعمل بحيث يكون لعدمه دخل في حصول العمل على وجهه، كما ذهب إليه الشيخ والمحقّق الخراساني، فالأصل عليه أيضاً هو البراءة.
إلّا أنّ المبنى مخدوش من حيث إنّ الشرط لابدّ وأن يكون مؤثّراً فيما هو المقصود، وعدم المانع - كسائر الأعدام - ليس له تأثير وتأثّر، هذا بحسب مقام الثبوت. وبحسب مقام الإثبات أيضاً الأدلّة الدالّة على الموانع تدلّ على خلاف ذلك. وإن قام دليل بظاهره يدلّ على شرطية عدم شيء لابدّ من حمله على خلاف ظاهره، وكون وجود ما عدمه في الظاهر اعتبر شرطاً مانعاً.
وعلى کلّ حال، فقد أفاد الشيخ(قدس سره): بأنّه إن زيد جزءٌ من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءاً مستقلّا، كما لو اعتقد شرعاً أو تشريعاً أنّ الواجب في کلّ ركعة ركوعان كالسجود، فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في
ص: 107
الأثناء؛ لأنّ ما أتى به وقصد الامتثال به - وهو المجموع المشتمل على الزيادة - غير مأمور به، وما أمر به - وهو ما عدا تلك الزيادة - لم يقصد الامتثال به.((1))
وأمّا صاحب الكفاية، فقال: لو كان عبادة وأتى به كذلك (يعني مع الزيادة عمداً تشريعاً أو جهلاً، وقصوراً أو تقصيراً، أو سهواً) على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه لكان باطلاً مطلقاً، أو في صورة عدم دخله فيه لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.
وأمّا لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أيّ حال، كان صحيحاً ولو كان مشرِّعاً في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله؛ فإنّ تشريعه في تطبيق المأتيّ مع المأمور به، وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرّب على کلّ حال.((2))
وخلاصة ما أفاد: أنّ الشكّ واقع في جزئية عدم الزيادة أو شرطيته، فيدخل في الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيين الجاري فيه البراءة الشرعية دون العقلية على مبناه من عدم الانحلال.
نعم، إذا دخل في التشريع بأن كان العمل عبادة، فيحكم بالبطلان. إلّا أنّه تردّد بين ما إذا أتى به على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما أتى به، فيبطل مطلقاً وإن كان له دخل فيه في الواقع؛ أو يبطل إذا لم يكن دخل للزائد فيه، لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة بخلاف الصورة الاُولى، ولكن مع الشكّ في الحال يجب الإعادة لقاعدة الاشتغال. وقد أفاد: أنّه لو أتى به على نحو يدعوه إليه على کلّ حال، سواء كان للزائد دخل في المأمور به أو لم يكن، صحّ.
ص: 108
ولكن فيه: أنّ عمله بالزيادة في الواجب تشريعاً يقع مبغوضاً للمولى، ولا يمكن التعبّد والتقرّب إليه بما هو مبغوض له، فتدبّر.
إذا دار الأمر بين كون شيء شرطاً للمأموربه أو مانعاً، أو بين أن يكون جزءاً له أو مانعاً، فهل مقتضى الأصل فيه البراءة أو التخيير أو الاحتياط؟
فنقول: أمّا البراءة فليس المقام مورد جريانها؛ لأنّها تجري في الشكّ في التكليف، وهنا يكون الشكّ في المکلّف به.
وأمّا التخيير، فما قيل في وجهه: أنّ الأمر دار بين المحذورين فلا يمكن الموافقة القطعية، فلابدّ من الاحتمالية، وحيث لا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر فهو مخيّر بين الفعل والإتيان بالمأمور به معه أو بدونه.
لا يقال: يمكن الموافقة القطعية بالتكرار.
فإنّه يقال: إنّه مستلزم لفوات ما يعتبر في العبادة من القصد التفصيلي والجزم بكون ما يأتي به مأموراً به.
ولكن يضعّف هذا الجواب أوّلاً بعدم الدليل على اعتبار الجزم في النيّة. وثانياً بأنّ هذا المحذور حاصل على القول بالتخيير أيضاً؛ لأنّ كون ما اختاره المأمور به الواقعي مشكوكٌ فيه، لأنّ التخيير يكون بحكم العقل وليس شرعياً.
وعلى ذلك کلّه، الأمر دائر في المقام بين المتباينين، لا الأقلّ والأكثر حتى يقال بالبراءة، ولا المحذورين حتى يقال بالتخيير، فلابدّ من الاحتياط بالتکرار. والله هو العالم.
إذا كان شيء جزءاً أو شرطاً للمركّب منه و من غيره مطلقاً حتى في حال العجز
ص: 109
عنه، يسقط الأمر به إن عجز عن هذا الشيء. وإذا كان جزءاً أو شرطاً له في صورة التمكّن منه، لا يسقط باقي الأجزاء بالعجز عنه كما هو واضح؛ لأنّ المأمور به في حال العجز سائر الأجزاء، هذا في مقام الثبوت.
وأمّا في مقام الإثبات، فإن كان هنا دليل على كونه هو المأمور به من الأوّل مثل: «لا صلاة إلّا بطهور»،((1)) فالمتّبع الدليل فيحكم بسقوط الأمر إذا كان
عاجزاً عن تحصيل الطهارة. كما أنّه لو دلّ الدليل على وجوب الصلاة مطلقاً مثل: «الصلاة لا تسقط بحال» فإن عجز مثلاً عن القيام لا يسقط الأمر بسائر الأجزاء بالعجز عنه.
وإن صار ذلك مورد الشكّ ، فلم يدر أنّ الجزء الّذي عجز عنه جزء له حتى في حال العجز عنه ليكون الأمر بالمركّب منه ساقطاً به، أو أنّه جزؤه في حال التمكّن منه؟ فمقتضی الأصل البراءة عن الباقي عقلاً ونقلاً، لكون الشكّ في وجوبه شكّ بدويّ.
هذا، وقد يقال بالتمسّك بالاستصحاب للحكم بوجوب الباقي؛ فإنّه كان قبل العجز عن هذا الجزء واجباً، فالآن يكون هو كما كان ويستصحب وجوبه السابق.
وفيه: أنّ ذلك لا يتمّ إلّا على القول بصحّة القسم الثالث من استصحاب الكلّي والجامع بين الوجوب المرفوع بالعجز والحادث المحتمل قيامه مقامه.((2)) أو أن يقال بالمسامحة العرفية((3)) في تعيين الموضوع في الاستصحاب لا الدقّة العقلية إذا كان ما يتعذّر ممّا يتسامح به عند العرف، فيقال ببقاء الوجوب النفسي المتعلّق بتمام الأجزاء ببقاء سائر الأجزاء. وبعبارة اُخرى يقال ببقاء الموضوع ببقاء الباقي من الأجزاء.
ص: 110
لا يقال: إنّ المستصحب الوجوب الضمني أو الغيري الّذي كان الباقي محكوماً به قبل حدوث العجز.
فإنه يقال: إنّه كان متفرّعاً على الحكم النفسي المتعلّق بالجميع وهو مشكوك البقاء، لعدم بقاء موضوعه بالعجز عن بعض أجزائه، فلا يصحّ الحكم ببقاء الفرع مع الشكّ في بقاء الأصل.
أقول: اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك من القسم الثاني من استصحاب الكلّي، لأنّ وجوب الباقي من الأجزاء يكون باقياً إن كان الوجوب المتعلّق بهذا الجزء مشروطاً بالتمكّن منه، وإن كان مطلقاً فالوجوب المتعلّق بسائر الأجزاء يرتفع بارتفاعه بالعجز، فعلى هذا يستصحب الوجوب الكلّي الجامع بينهما.
إعلم: أنّه قد استدلّ على وجوب باقي الأجزاء على العاجز بما يعبّر عنه بقاعدة الميسور. وبناءً عليها لا يسقط واجب بمجرّد العجز عن بعض أجزائه، فضلاً عن أفراده إذا كان المأمور به على نحو العامّ المجموعي. وأمّا إذا كان على وجه العامّ الاستغراقي فلا ريب في عدم سقوط سائر الأفراد.
وهذه القاعدة إن ثبتت، فهي قاعدة شرعية تعبّدية ليست عقلية.
واستدلّ عليها مضافاً إلى الاستصحاب المذكور - وإن كان هو مخصوصاً بموضوعات يتسامح العرف فيه في الحكم ببقائه، نظير استصحاب كثرة الماء وقلّته - بروايات ضعيفة السند ادّعي جبر ضعف إسنادها بالعمل.
وردّ ذلك بعدم العمل بها في غير باب العبادات، بل ولم يعملوا بها في غير الصلاة كالصوم والحجّ، بل في باب الصلاة أيضاً ذلك بدليل خاصّ بأنّها لا تسقط بحال.
ص: 111
وكيف كان، فمن هذه الروايات، المرويّة في عوالي اللئالي - وهو كتاب لا يعتمد عليه، حتى أنّ مثل صاحب الحدائق(رحمه الله) تصدى للقدح عليه، ومن لاحظه يرى أنّ مؤلّفه جمع فيه الغثّ والسمين. وما نسبه إلى أمير المؤمنين(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «الميسور لا یترك بالمعسور».((1))
بيان الاستدلال به: أنّ المراد منه النهي بلسان النفي ودعوى ظهوره في النهي المولوي وما يجب معسوره، حتى يصدق عدم سقوط ميسوره به، ونسبة السقوط إلى المندوب وإن كان جائزا إلّا أنّه في الواجب أظهر.
وبهذا يمكن الجواب عمّا ذكره من الإشكال في الكفاية،((2)) وهو: أنّ شمول الميسور للمندوب يمنع عن اختصاصه بالواجب والدلالة على اللازم. مضافاً إلى ما أفاده بنفسه((3)) من جواز كون المراد منه: أنّ الحكم الميسور - واجباً كان أو مندوباً - لا يسقط بالمعسور.
وأفاد بعض الأجلّة بما حاصله: أنّ المراد: أنّ الميسور من المعسور مطلوب لا يسقط الطلب المتعلّق به بسقوطه عن المعسور، والوجوب أو الندب ليس داخلاً في مفهوم الطلب، وإنّما يستفاد الوجوب بحكم العقل بلزوم الإطاعة والنهي بترخيص الشارع ترك المأمور به. لا يقال: إنّ النهي - سواء كان مولوياً أو إرشادياً - يتعلّق بفعل المكلّف وما هو تحت قدرته واختياره، وسقوط الواجب أو ثبوته في ذمّة المکلّف ليس تحت اختياره، فما معنى النهي عن سقوطه؟
فإنّه يقال: المراد منه أنّ الميسور حيث لا يسقط بالمعسور، لا يجوز تركه.
مضافاً إلى أنّه نهي عن إسقاط الميسور عملاً لا تشريعاً.
وبالجملة: إنّ المراد تشريع عدم السقوط، فهو الدليل على وجوب الميسور. وإن
ص: 112
كان المراد النهي عن عدم سقوط الميسور يكون المراد إسقاطه عن العمل وتركه. وبالجملة: المفهوم من هذه الجملة هو النهي عن ترك الميسور لأجل تعذّر الميسور.
واستشكل في الاستدلال به أوّلاً: أنّه لم يظهر منه أنّ المراد منه عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها، فلعلّ المراد منه عدم سقوط أفراد العامّ بما يعسر الإتيان به منها.
وثانياً: على فرض دلالته على المطلوب يلزم منه كثرة التخصيص المستهجن لكثرة الموارد الساقطة فيها الميسور بالمعسور. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الموارد المذكورة ليس الميسور من الأجزاء عرفاً ميسوراً للمأمور به.
ومنها: ما روي عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) في حديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».((1))
والاستدلال به متوقّف على كون المراد من «شيء» المركّب من الأجزاء.((2)) وتكون کلمة «ما» موصولة، مفعولاً لقوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «فأتوا»، حتى يكون مفاد الحديث: وجوب الإتيان بالمقدور من الأجزاء والشرائط.
ولكنّه لا ينطبق على مورد الرواية؛ فإنّ السائل عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) سأله عن وجوب الحجّ في کلّ عام، فأجابه بقوله: «ويحك... فإذا أمرتكم...». هذا مضافاً إلى أنّ بعض النسخ ليس فيه کلمة «منه»، وعليه تكون کلمة «ما» زمانية.
ومنها: ما عن أمير المؤمنين(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) أنّه قال: «ما لا يدرك کلّه لا يترك كلّه».((3))
وما يمكن أن يكون المراد منه هو أن يكون المراد من کلمة «كلّ» المذكورة فيه في
ص: 113
الفقرتين کلّ الأفراد على سبيل الاستغراق، أو کلّ أبعاض الشيء على نحو العامّ المجموعي، أو كان الأوّل على الأوّل، والثاني على الثاني، أو بالعكس.
أمّا الوجه الأوّل، فالمراد منه ما لا يدرك کلّ أفراده ويدرك بعضها لا يترك کلّه أي بعضه الّذي يدرك.
وأمّا الوجه الثاني، فالمراد منه أنّ ما لا يدرك بجميع أجزائه ويدرك ببعضها لا يترك کلّها أي بعضها الّذي يدرك.
وأمّا الوجه الثالث والرابع، فلا يستقيم بهما المعنى والارتباط بين الجملتين.
ص: 114
إعلم: أنّه وإن حكي عن بعض أنّ الشرط في جواز إجراء کلّ واحد من الاحتياط والتخيير والبراءة الفحص عن الدليل في مورده واليأس عن الظفر به؛ وذلك لتوهّم اعتبار نيّة الوجه بالتفصيل في العبادات. إلّا أنّه ردّ بعدم دليل على اعتباره، بل القطع حاصل لعدم وجوده في الأخبار، ولا يكون فيه إجماع محقّق، فالأصل عدم اعتباره. مضافاً إلى أنّ القصد والنيّة من شؤون الإطاعة والامتثال، والحاكم فيها هو العقل وهو لا يعتبر في حصول الامتثال إلّا قصد إطاعة أمر المولى ولو أتى به رجاءً وكان داعيه احتمال أمر المولى.
وبالجملة: لا ريب في أنّ الاحتياط بإتيان جميع ما يحتمل دخله في المأمور به يكفي في الامتثال ولا ريب في حسنه. وأمّا توهّم((1)) كون الاحتياط بتكرار الفعل عبثاً أو لعباً بأمر المولى، وهو ينافي قصد الامتثال والتقرّب فمدفوع بمنع كونه كذلك إذا كان بداعٍ عقلائيّ ولو كان ذلك تحصيل القطع بإدراك الواقع. هذا کلّه في إجراء الاحتياط.
وأمّا البراءة: فالعقلية منها لا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجّة على التكليف؛ لوضوح أنّ العقل لا يستقلّ بجواز إجرائها قبل الفحص واليأس، بل مستقلّ بعدم جواز إجرائها واستحقاق العبد للعقاب لو وقع في مخالفة المولى.
ص: 115
وأمّا البراءة النقلية: فلا ريب في انصراف أدلّتها إلى صورة الفحص عن الحجّة على التكليف وعدم الظفر بها، فلا إطلاق لها يشمل صورة عدم الفحص، لاستلزامه تفويت أكثر مقاصد الشارع سيّما مع العلم الإجمالي بثبوت تكاليف بين موارد الشبهات لو فحص عنها لظفر بها. هذا مضافاً إلى الإجماع((1)) وقيام السيرة المستمرّة على ذلك. ويدلّ عليه أيضاً من الآيات والروايات ما دلّ على وجوب التفقّه والتعلّم وتحصيل العلم بالحلال والحرام. ولا ريب في تقديم هذه الأدلّة على أدلّة البراءة وتقييدها بها.
وأمّا التخيير العقلي: فالكلام فيه هو الكلام في البراءة العقلية.
هذا کلّه في شرط العمل على طبق البراءة والتخيير.
بقي الكلام في آثار البراءة إن عمل بها قبل الفحص، ثم بيان أحكامها بعد العمل بها كذلك.
أمّا الكلام في آثار العمل بها قبل الفحص، فلا شكّ في استحقاق العقاب إن وقع في مخالفة المولى.
نعم، قد وقع الكلام بينهم في أنّ ذلك يكون بترك التعلّم، أو يكون على مخالفة الواقع، فيه قولان:((2))
أحدهما مبنيّ على كون وجوب التعلّم والتفقّه نفسياً، كما هو مختار الأردبيلي((3))
ص: 116
وصاحب المدارك،((1)) وصاحب الكفاية.((2)) وقد تفصّوا به عن الإشكال الوارد على القول بأنّ استحقاق العقاب يكون على مخالفة الواقع وهو أنّه على هذا القول في الواجب المشروط والموقّت كالحجّ لا يجب تحصيل المقدّمات قبل حصول الشرط أو حضور الوقت، فإن أدّى ذلك إلى عدم التمكّن من الإتيان بالواجب كيف يصحّ القول باستحقاق العقاب على تركه وإن التفت إلى الخطاب الواقعي بعدهما. وبالجملة لا يتنجّز بالنسبة إليه الخطاب أوّلاً لعدم تمكّنه من الامتثال. وثانياً لأنّه بعدما ترك التعلّم يكون جاهلاً وغافلاً عنه ولا يمكن تنجّز الخطاب الواقعي المطلق بالنسبة إلى الجاهل والعالم بالنسبة إليه لأنّ تنجّزه متفرّع على علمه به. وعلى ذلك يرد هذا الإشكال على القول بالواجب المعلّق، بل وعلى سائر الواجبات المطلقة فلا يكون مصحّحاً لاستحقاق العقاب في البين إلّا القول بوجوب التعلّم نفسياً.
ثانيهما: أنّ وجوب التعلم إرشادي ويكون الاستحقاق على مخالفة الواقع إن أدّى ترك التعلّم إليه.
وممّا اُخذ على القائل بالوجوب النفسي أنّه مستلزم لاستحقاق التارك للتعلّم - الواقع في مخالفة الواقع - عقابين أحدهما على ترك التعلّم، وثانيهما على مخالفة الواقع؛ في حال كون العالم بالتكليف التارك له عصياناً مستحقّاً لعقوبة واحدة، مع أنه يمكن دعوى القطع بخلافه.
والّذي يختلج بالبال في ردّ الإشكال الّذي توهّمه القائل بالوجوب النفسي للتعلّم: أنّه يكفي في صحّة العقاب على وقوع المکلّف في مخالفة الواقع كونه متذكّراً بأنّ للشارع خطابات واقعية مطلقة غير مقيّدة بالعلم والجهل والالتفات والغفلة، لأنّ
ص: 117
تقييدها بها مستلزم للدور، فيجب عليه التعلّم؛ لأنّ الشارع أنشأ هذه الخطابات ليعلم المکلّف بها. بل يكفي في وجوب أن يكون في مقام التعلّم أن يكون شاكّاً في ذلك، فلا يجوز له عدم الاعتناء بما يحتمل اعتناء المولى به، ويكفي في استحقاقه العقاب على مخالفة الواقع تركه التعلّم.
لا يقال: إذا كان شاكّاً في أمر المولى وخطابه إليه يكون العقاب على مخالفته العقاب بلا بيان.
فإنّه يقال: ليس الأمر كذلك مطلقاً وإن ترك الفحص الممكن عن أمره، وإلّا فهو كاشف عن عدم اعتنائه بأمر المولى واستخفافه به، فعبوديته للمولى و اعتناؤه بأمره تقتضي ذلك. والله هو العالم.
وأمّا الكلام في أحكام العمل بالبراءة قبل الفحص، فاعلم: أنّ السيّد الاُستاذ(قدس سره) أفاد بأنّ الأحكام المترتّبة على العمل بها قبل الفحص إمّا تلاحظ بالنسبة إلى من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، وإمّا بالنسبة إلى المجتهد.
أمّا المقلّد فتارة: يقع البحث في تكليف نفسه. واُخرى: في حكم يفتي به المفتي إذا استفتاه المقلّد من الواقعة.
أمّا المقلّد نفسه، فلا ريب في أنّه بعد العمل إذا التفت إلى أنّ له أحكاماً فشكّ لذلك في صحّة عمله، يجب عليه الرجوع إلى مجتهد يجب الرجوع إليه في هذا الحال، أي حال الشكّ والسؤال، فما أفتاه به فيه هو الحجّة له وعليه.
وأمّا المفتي، فيلاحظ تفاصيل الواقعة، فإن رأى أنّ عمل المقلّد وقع مطابقاً لفتوى من فتواه حجّة في حقّه حين العمل ومطابقاً لفتوى نفسه، فلا إشكال في صحّة عمله
ص: 118
ظاهراً، فيفتي بصحّته. وأمّا إن اختلفت الفتويان، فإن وقع مخالفاً لرأي من كان رأيه حجّة في حقّه حين العمل، وموافقاً لرأي من رأيه حجّة حين التذكّر والسؤال، كأن كان رأي الأوّل بطلان الصلاة بلا سورة، وهو أتى بها فاقدة لها، ورأي الثاني عدم وجوب السورة وصحّتها بدونها، فإن كان مستند رأي المفتي الثاني القطع أو الدليل القاطع الّذي يكون بحيث يقطع به بخطأ الأوّل، فلا ريب في أنّ الواجب عليه أن يفتي بصحّته، فإنّه يرى عمله مطابقاً للواقع وإن كان مخالفاً لرأي من كان يجب عليه تقليده حين العمل، فإنّ مخالفة العمل للطريق لا تضرّ بصحّة العمل إذا كان مطابقاً للواقع.
وأمّا إن كان مستند رأي المفتي أصل البراءة من وجوب السورة مثلاً، فلا يجوز له الإفتاء بصحّة العمل؛ فإنّ البراءة إنّما تجري إذا لم تكن حجّة على الحكم، وقول المفتي السابق بالوجوب كان عن حجّة، فلا يجوز للمفتي الّذي يقول بعدم الوجوب بالبراءة الفتوى بالصحّة؛ لأنّ العامل يرى عمله باطلاً مخالفاً للحجّة ومطابقته للواقع مشكوكة.
وهكذا يجري الكلام في الخبرين المتعارضين المتكافئين على القول بالتخيير الشرعي، فإنّ الحجّة على الحكم ما يختاره المفتي، وما اختاره المفتي الأوّل جزئية السورة وهو حجّة للمقلّد ويكون عمله السابق مخالفاً للحجّة، وما اختاره المفتي الثاني حجّة له لا تنفى به حجّية فتوى الأوّل ولا كونها على خلاف الواقع، فلا تؤثّر في ثبوت عدم الجزئية في زمان العمل، لأنّ حجّية أحد المتعارضين إنّما تكون من زمان اختياره لا قبله. مضافاً إلى أنّ حجّية کلّ واحد منهما باختيار هذا المجتهد أحدهما والآخر غيره لا تعارض حجّية الآخر.
هذا کلّه في صورة المخالفة مع رأي السابق والموافقة مع اللاحق.
وأمّا صورة المطابقة مع رأي السابق والمخالفة مع اللاحق، فالحكم بالصحّة مبنيّ على القول بالإجزاء. مضافاً إلى كفاية مجرّد موافقة العمل مع الحكم الظاهري وعدم
ص: 119
اعتبار البناء عليه في الإتيان بالعمل، وهذا هو نتيجة التحقيق في المسألة لظهور أدلّة الاُصول والأمارات على الإجزاء ولو بالموافقة الاتّفاقية، وقد مرّ البحث عن ذلك في مبحث الإجزاء.
ثم إنّ ما ذكر، کلّه في العبادات. وأمّا المعاملات فوقوع المعاملة على طبق الأمر الظاهريّ والحجّة، ككون العقد بالفارسية سبباً للملكيّة، في مقام الثبوت ممكن.
وفي مقام الإثبات أيضاً، فمقتضى أدلّة الاُصول والإطلاقات حصول الملكية بذلك. إلّا أن يقال بأنّ المعاملات تعتبر وجودات باقيات إلى زمان المفتي اللاحق وبعده، ويكون الوجود البقائي منها كالوجود الحدوثي منها يحتاج في ترتّب الآثار عليه إلى فتوى المفتي اللاحق. ولكن ذلك وجه ضعيف لا يوافق سماحة الشريعة وقوّة أحكامها.
إعلم: أنّه قد خرج عن الكليّة المذكورة - أي وجوب الإعادة أو القضاء على الجاهل المتمكّن عن التعلّم إذا وقع في مخالفة الواقع - موردان، أحدهما: الإتمام في موضع القصر. وثانيهما: الجهر أو الإخفات في موضع الآخر. وأصل الحكم منصوص عليه((1)) والمفتى به بين الأصحاب((2)) فلا ريب في صحّة صلاة الجاهل بوجوب القصر تماماً، والجاهل بوجوب الجهر إخفاتاً، أو الجاهل بوجوب الإخفات جهراً، سواء كان قاصراً أو مقصراً.
ص: 120
ولذا أشكل الأمر في مقام الثبوت من جهتين:
إحداهما: أنّه إذا كان الأمر الواقعي متعلّقاً بالإخفات أو الجهر تكون الصلاة المأمور بها والمنجّز عليها غير ما أتى بها، والمأتيّ بها غير المأمور بها، فكيف يحكم بصحتّها مع أنّ صحّة المأتيّ بها تتوقّف على كونها على طبق ما اُمر بها؟!
وثانيتهما: أنّه كيف يجوز العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها مع إمكان إعادتها، وبعبارة اُخرى: إن كانت الصلاة المأتيّ بها موجبة لسقوط الأمر فما وجه استحقاق العقوبة؟ وإن لم تكن كذلك فما وجه عدم وجوب الإعادة؟!
وأجاب السيّد الاُستاذ عن الاُولى أوّلاً: بأنّه يجوز أن تكون تلك الصلاة مأموراً بها على نحو الترتّب، فهي تكون صحيحة لأنّها وقعت على وفق الأمر الترتّبي.((1)) وثانياً: أنّ الصحّة ليست عبارة عن وقوع الفعل على وفق الأمر، بل يكفي في صحّته كون الفعل واجداً لمصلحة تامّة في حدّ ذاته، وعدم الأمر به لمزاحمته مع ما يكون أقوى منه وأتمّ.
وأمّا الجواب عن الإشكال الثاني: أنّ استحقاق العقوبة لأجل أنّ المكلّف فوّت المصلحة الأقوى الكامنة في الفعل ولا يمكن استيفاؤها بعد استيفاء المصلحة الكامنة فيما أتى به من الجهر مثلاً في موضع الإخفات.((2))
واُورد على ذلك ما أفاده في الكفاية بقوله: «إن قلت: على هذا يكون کلّ منهما في موضع الآخر سبباً لتفويت الواجب فعلاً، وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام، وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام.
ص: 121
وردّه: بأنّه ليس سبباً لذلك. غايته أنّه يكون مضادّاً له، والضدّ ليس سبباً لعدم ضدّه، بل يكون مقارناً له، ومجرّد المقارنة لا يجعله حراماً حتى يوجب فساده.((1))
ولكنّ السيّد الاُستاذ أفاد بأنّ کلّ واحد منهما سبب لتفويت الآخر، لا من باب التضادّ؛ فإنّ الضدّين - كما أفاد - ليس کلّ منهما سبباً للآخر، ولكن حقيقة التضادّ الواقع بين الضدّين عدم إمكان اجتماعهما في زمان واحد وفي موضوع واحد، وفي المقام يكون کلّ منهما سبباً لعدم الآخر في هذا الزمان وفي بعده من الأزمنة الاُخرى. وبعبارة اُخرى: تفويت الواقع بالصلاة المأتيّ بها ليس من جهة عدم اجتماعه معها بالذات ومضادّتهما، فإنّه يمكن اجتماعهما معاً بإتيان الواقع في الزمان اللاحق، بل يكون لأجل علّية ما أتى به لفوت الواقع، وعلى هذا تقع هذه الصلاة علّةً لفوت الواقع مبغوضة للمولى لا يصحّ التقرّب بها إلى المولى.((2))
وبعد ذلك أفاد في مقام الذبّ عن هذا الإشكال: أنّ الدليل الّذي يدلّ على صحّة ما أتى به الجاهل يكشف عن عدم كون العمل عصياناً للواقع؛ لأنّ العمل الصادر عنه في هذا الحال يكون وافياً بتمام مصلحة الواقع في غير حال الجهل به، فهو يكون مسقطاً للأمر الواقعي، فلا يكون في البين تفويت وعصيان.
وأمّا دعوى الإجماع على أنّ الجاهل المقصّر مستحقّ للعقاب حتى في هذه الموارد الثلاثة.
فممنوعة((3)) في خصوصها ولو بلحاظ ما ذكر. فليس للمولى - إذا كان ما أتى به عبده في هذا الحال وافياً بتمام مراده - عقوبة العبد على ترك ما أمر به، مع أنّه لم يفوّت من غرضه شيئاً. اللّهمّ إلّا أن يكون ذلك بتجرّيه عليه. فلم تتحقّق من العبد معصية
ص: 122
حقيقية، وإنّما تكون عدم موافقة العبد أمر مولاه موجباً لجواز عقوبته إذا كان عدم الموافقة زائداً على ذلك مفوّتاً لغرض المولى.
قد ذكر هنا لجواز إجراء الأصل شرطان آخران:((1))
أحدهما: أن لا يكون موجباً لثبوت حكم شرعيّ آخر، كما إذا كان شاكّاً في اشتغال ذمّته بدين بحيث إن كانت ذمّته مشغولة به يمنعه ذلك الدين من حصول الاستطاعة، إلّا أنّه لو أجرى أصالة البراءة عن هذا الدين تحصّل له الاستطاعة.
والوجه في ذلك: أنّ الأصل المذكور إنّما شرّع امتناناً على العباد، وليست في إجرائه لنفي تكليف إذا كان موجباً لإثبات تكليف آخر منّة على العبد.
والجواب عن هذا الشرط: أنّ أدلّة البراءة بإطلاقها تجري في الشبهة البدويّة مثل اشتغال ذمّته بدين لعمرو، وذلك وإن كان ملازماً لتعلّق تكليف آخر به مثل الحجّ المشروط بالاستطاعة لا يمنع من إجراء البراءة عن اشتغال ذمّته بالدين. أمّا البراءة العقلية، فإنّه بحكم العقل لا يكون مستحقّاً للعقوبة على ترك أداء الدين المجهول اشتغال ذمّته به. وأمّا النقلية، فأدلّتها مطلقة. والملازمة بين نفي الدين وحصول الاستطاعة لا تمنع من إجراء هذا الأصل. ولا ينافي كون نفي «ما لا يعلمون» امتناناً مطلقاً.
ثانيهما: أن لا يكون موجباً للضرر على آخر.
وهذا الشرط أيضاً ليس في محلّه؛ لأنّ الموضوع للبراءة هو خلوّ الواقعة عن دليل اجتهاديّ، لا ما إذا كان هنا دليل اجتهادي، ففيما إذا حبس شاة فمات ولدها، أو
ص: 123
أمسك رجلاً فهربت دابّته، لا تجري أصالة البراءة لنفي ضمان الحابس والممسك، لا لأنّ ذلك موجب للضرر على المالك، بل بالدليل الاجتهادي مثل «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»،((1)) أو «الممسك ضامن للمالك»، فلا موضوع للبراءة إذا كانت هناك قاعدة الضرر، أو أيّ دليل اجتهادي آخر، فتدبّر.
وهاهنا صار المجال للاستطراد بذكر قاعدة الضرر كما فعله الشيخ((2)) وتلميذه المحقّق الخراساني،((3)) فنبدأ ببيان هذه القاعدة.
ص: 124
إعلم: أنّ مفاد قاعدة لا ضرر على الإجمال، بغضّ النظر عن تفاصيله وما قيل في شموله أو عدم شموله لبعض الموارد، ثابت بحكم العقل، لا يجوز أن تكون شريعة الإسلام الجامعة الكاملة المنزّهة عن النقصان خاليةً عن مثله، فكمال الشريعة يقتضي حكمها به.
وقد دلّت عليها الأخبار المستفيضة القطعية، بل المتواترة.
منها: ما يكون - على ما أفاده سيّدنا الاُستاذ، وهو خرّيت صناعة علوم الحديث ومعرفة أسانيدها وصحاحها وضعافها وعللها ومسانيدها ومراسيلها - أصحّ سنداً وأوضح دلالة،((1)) وهو: ما رواه غير واحد عن زرارة في قصّة سمرة بن جندب عن أبي جعفر(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: «إنّ سمرة بن جندب كان له عذق((2)) وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجى ء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري، فقال له الأنصاري: يا سمرة! لا تزال تفجأنا على حال لا نحبّ أن تفاجئنا عليه، فإذا دخلت فاستأذن، فقال: لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي. قال: فشكاه الأنصاري إلى رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، فأرسل إليه رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فأتاه، فقال له: إنّ فلاناً قد شكاك وزعم أنّك
ص: 125
تمرّ عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال: يا رسول الله! أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) خلّ عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك إثنان، قال: لا اُريد، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق، فقال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا، فأبى، فقال: خلّ عنه ولك مكانه عذق في الجنّة، قال: لا اُريد، فقال له رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) إنّك رجل مضارّ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال: ثمّ أمر بها رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فقلعت ثم رمي بها إليه، وقال له رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): انطلق فاغرسها حيث شئت».((1)) ثم إنّ السيّد الاُستاذ - كما حكى عنه المقرّر الفاضل((2)) - أفاد بإمكان القطع بصدور قضيّة «لا ضرر ولا ضرار» مضافاً إلى أنّ
ص: 126
المشهور عملوا بها، وهذا بنفسه يكفي في صحّة الاحتجاج بها والعمل عليها، وهذا ممّا لا شبهة فيه، إلّا أنّ الكلام وقع في جهات:
قال في الكفاية: إنّ الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل العدم والملكة، كما أنّ الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جيء به تأكيداً، كما يشهد به إطلاق المضارّ على سمرة، وحكي عن النهاية لا فعل الاثنين... إلخ».((1))
وبعبارة اُخرى: التقابل بين الضرر والنفع هو عبارة عن عدم وصف لموضوع كان ينبغي أن يكون له ويوجد متّصفاً بذلك الوصف، سواء لوحظ ذلك بالنسبة إلى شخص الموضوع أو نوعه أو جنسه، فعدم الشيء - في مقابل وجوده حيث تكون له شأنية حصوله - يكون من الضرر، والمقابلة بينهما تكون مقابلة العدم والملكة كالعمى بالنسبة إلى البصر.
ولكن أفاد السيّد الاُستاذ بأنّ هذا المعنى خلاف التحقيق؛ لأنّ الضرر عند العرف أمر وجوديّ يعبّر عنه بالنقص. كما أنّ ما يقابله أي النفع أمر وجوديّ وهو زيادة رأس المال. بل يعتبر بينهما الواسطة وهو عدم تغيّر رأس المال وبقاؤه على حاله من دون نقص ولا زيادة.((2))
وفيه: أنّ تصديق ذلك لا يخلو من الإشكال، فإنّ على ذلك إذا كان رأس المال مثلاً مأة درهم ثم رجع إلى تسعين يكون الأمر الوجودي هو التسعين الّذي يعبّر عنه بالنقص، دون العشرة الّتي نقصت من رأس المال، مع أنّ العرف يعتبر هذه العشرة نقصاً، وهي الّتي كانت من شأنها البقاء. والنفع يكون على ذلك ما يزيد على المأة،
ص: 127
والواسطة بقاء رأس المال على حاله. إلّا أن يقال: إنّ الضرر عبارة عن عدم النفع، أي عدم الزائد على المأة وما كان من شأنه أن يكون ويزيد.
وعلى الوجهين ليس الضرر أمراً وجودیّاً، بل هو عدم أمر وجودي كان من شأنه أن يوجد.
والظاهر أنّ الضرر يطلق على الأوّل إن اُريد منه الضمان، فإنّه إذا تنزّل بفعل شخص رأس ماله الّذي كان مأة إلى تسعين هو يكون ضامناً للعشرة الّتي نقصت عنه إن كان بالعين دون القيمة.
وأمّا إذا لم يحصل لصاحب رأس المال بفعل غيره ما كان مترقّباً من الزيادة فلا يكون ضامناً. نعم، لا يجوز له ذلك تكليفاً.
فعلى الأوّل يكون معناه: لا ضرر غير المتدارك. وعلى الثاني: لا يجوز الضرر ومنع النفع. والله هو العالم.
إعلم: أنّ کلمة «لا» في قوله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «لا ضرر ولا ضرار» لمّا كانت لنفي الجنس ونفي مدخولها لابدّ وأن تكون مستعملة في غير معناه الحقيقي، لوجود مدخولها في الخارج وهو قرينة على أنّ المراد غير معناه الحقيقي.
وقد قيل في ما هو المراد منها وجوه وأقوال:
أحدها: أن يكون المراد من النفي: النهي عن الضرر، سواء كان بنفسه أو غيره، فيكون معناه تحريم الإضرار بالنفس وبالغير، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدالَ في الْ-حَجِّ﴾((1)) وهذا مختار صاحب الجواهر.
ص: 128
وهو خلاف الظاهر.
ثانيها: أن يكون المراد منه نفي الضرر غير المتدارك((1)) ليكون معناه أنّه لن يصل من أحد ضرر إلى غيره إلّا وهو متدارك بالشرع ويجبره الشارع ويدفع بحكمه.
وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ لاستلزامه استعمال الضرر وإرادة خصوص الغير المتدارك.
ثالثها: أنّ المعنى عدم تشريع الضرر، وأنّ الشارع لم يشرع حكماً فيه الضرر، سواء كان تكليفياً كالوضوء الضرري، أو وضعياً مثل لزوم البيع مع الغبن، وهذا مختار الشيخ الأنصاري.((2))
وفيه أيضاً أنّه خلاف الظاهر؛ لمكان احتياجه إلى تقدير وإضمار.
رابعها: أنّ المراد منه - كما أفاد في الكفايه((3)) - نفي الحقيقة، كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادّعاءً كنايةً عن نفي الآثار والأحكام المترتّبة على الموضوعات.
وبعبارة اُخرى: نفي الآثار والأحكام بالإرادة الجدّية المبرزة بالإرادة الاستعمالية وبنفي الحقيقة استعمالاً. ومثل هذا الاستعمال شائع في المحاورات، نظير قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد»؛((4)) و«يا أشباه الرجال ولا رجال».((5)) وهذا تأكيد لعدم ترتّب الأثر على العمل بنفي أصل العمل، وهو من البلاغة في الكلام؛ فإنّ نفي ما يترتّب على العمل من الأثر بنفيه حقيقةً بليغ جدّاً.
ص: 129
ولكن ضعف هذا الوجه أيضاً، - كما في تقريرات سيّد الاُستاذ:((1)) بأنّ نفي الحكم والأثر بنفي الموضوع إنّما يصحّ إذا كان الحكم المنفيّ حكم نفس الموضوع مثل: عنوان الصلاة في قضيّة «لا صلاة لجار المسجد»، وأمّا إذا كان ذلك بلسان نفي موضوع لنفي حكم موضوع آخر، فلا يصحّ. وفي المقام لا ينفى بنفي الضرر حكمه، بل ينفى به الحكم المترتّب على الموضوعات والأفعال بعناوينها الأوّلية مثل وجوب الوضوء، وذلك لا يصحّ وغير شائع في المحاورات، فالحكم الثابت لعنوان الضرر مثلاً على الغير لا يكون منفيّاً حتى يريد بنفيه نفيه، والحكم الثابت للوضوء الضرري أي وجوبه، ليس هو حكم الضرر بل هو حكم الوضوء. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الوضوء الضرري من أفراد الوضوء الواجب.
وكيف كان، فيمكن أن يقال: إنّ عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقهً ولا ادعاءً قرينة على أنّ المتكلّم أراد واحداً من هذه الوجوه. ويمكن أن يقال: إنّ الأظهر منها بمناسبة مقام الشارع نفي الأحكام الموجبة للضرر.
هذا، وممّا ذكر ظهر ما هو النسبة بين أدلّة الضرر والأحكام الأوّلية، وأنّ الاُولى حاكمة على الثانية مطلقاً((2)) وإن كانت النسبة بينهما عموماً من وجه، كالوضوء الواجب بالحكم الأوّلي، والضرر المنفيّ بالحكم الثانوي.
نعم، إذا كان دليل الحكم الأوّلي دالّا على ثبوت الحكم مطلقاً وبنحو العلّية التامّة يكون دليل الحكم الثانوي منصرفاً عنه لا يكون حاكماً عليه وإن لم نقل بالانصراف يكون محكوماً له.
هذا بالنسبة إلى نسبته مع الحكم الأوّلي. وأمّا مع الحكم الثانوي الآخر كدليل نفي
ص: 130
العسر والحرج، فالنسبة بينهما تكون التعارض، فيلاحظ الدليل الأرجح والأقوى إن كان في البين، وإلّا فالمرجع لرفع التعارض ما قرّر بالأخبار.
هذا، إن كان التعارض بوجود مقتضٍ واحد بين المتعارضين لا يعلم أنّه لأيّهما يكون بالخصوص، وهو الملاك في باب التعارض بخلاف باب التزاحم، فإنّ فيه يكون المقتضي موجوداً في کليهما فلابدّ من ملاحظة ما هو الأقوى من المقتضيين وتقديمه على الآخر إن كان، وإلّا فهو بالخيار.((1))
ولا حول ولا قوّة إلّا بالله. وهاهنا نختم الكلام في البراءة ونسأل الله تعالى معرفة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين؛ فإنّها البراءة من النار، قال رسول(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «معرفة آل محمد براءة من النار، وحبّ آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب».((2))
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. اللّهمّ اغفر ذنوبنا، وكفّر عنّا سيّئاتنا، وتوفّنا مع الأبرار.
ص: 131
ص: 132
ولابدّ فيه من تقديم اُمور:
الأوّل: اعلم: أنّ کلما تهم حول تعريف الاستصحاب وإن تفاوتت واختلفت في اللفظ((1)) إلّا أنّها متّحدة بالمعنى والمضمون، فله عندهم معنى واحد ومرادهم منه فارد وهو: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه؛ أو بتعبير جاء في تقريرات السيّد الاُستاذ(قدس سره) أنّه: حكم الشرع ببقاء ما ثبت في مقام الشكّ في بقائه؛ أو غير ذلك. هذا هو الاستصحاب بحسب الاصطلاح. والتعريفات كما قيل((2)) من شرح الاسم وليس بالحدّ والرسم.
والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في إمكانه، ولذا يجوز البحث عن وقوعه أو نفيه، وهذا مع غضّ النظر عمّن يقول باستحالة التعبّد بالظنّ مطلقاً.
ثم إنّه لا يضرّ بما قلنا من وحدة مرادهم من الاستصحاب اختلافهم فيما هو دليله
ص: 133
من بناء العقلاء، أو الظنّ الحاصل عن ملاحظة ثبوت شيء سابقاً، أو الأخبار، فلا يوجب ذلك اختلافهم في المدلول كما لا يخفى.
الثاني: لا يخفى عليك: أنّ البحث عن حجّية الاستصحاب بحث عن مسألة اُصولية لوقوعه في طريق استنباط الحكم الفرعي. وليس مفاده حكم العمل بلا واسطة ولذا قد لا يكون مجراه إلّا الحكم الاُصولي كالحجّية.
وبالجملة: يبحث في حجّية الاستصحاب عن قاعدة کلّية تنطبق على مصاديقها وهي: حجّية وجوب شيء أو حرمته مثلاً في زمان سابق للحكم ببقائه عند الشكّ في بقائه في الزمان اللاحق.
هذا، وعلى القول بكون موضوع علم الاُصول هو الحجّة في الفقه - كما نبّه عليه السيّد الاُستاذ وتبعه بعض الأعلام من معاصريه في حاشيته على الكفاية - يقال في اُصولية المسألة: إنّ البحث في الاستصحاب واقع في أنّ وجوب شيء في زمان هل يكون حجّة على بقائه في زمان شكّ في وجوبه.
وكيف كان، فلا فائدة لهذا البحث إلّا اصطلاحياً وأنّ البحث عن حجّية الاستصحاب ليس من المبادي ولا من المسائل الفقهية بل يكون من المسائل الاُصولية.
هذا، إن قلنا بأنّ علم الاُصول علم مستقلّ، وأمّا إن قلنا بأنّه عبارة عن عدّة مسائل من علوم متفرّقة لها دخل في الاستنباط فالأمر واضح.
الثالث: لا ريب في أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أمران: اليقين بثبوت شيء والشكّ في بقائه، ولا يمكن ذلك إلّا باتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة من حيث المحمول والموضوع، فإنّه لو كان متعلّق إحداهما غير ما هو المتعلّق للاُخرى لا يصدق على الشكّ العارض الشكّ في بقاء المتيقّن.
ومن جانب آخر: الشكّ المذكور لا يطرأ إلّا من جهة وقوع التغيّر في بعض ما كان
ص: 134
عليه المتيقّن؛ إذن فكيف يتحقّق ما يعتبر في جريانه من اتّحاد القضيّتين؟ فإن لم يحدث في المتيقّن التغيّر لا يطرأ الشكّ في البقاء وإن طرأ التغيّر ينتقض به الاتّحاد المذكور.
ويجاب عن ذلك بأنّ الاتّحاد المذكور إن كان بنظر العقل وبالدقّة العقلية يرد الإشكال وينتقض اتّحاد القضيتين ولا يبقى معه مورد لإجراء الاستصحاب. ولكن إذا كان ذلك بنظر العرف - كما هو كذلك - لا يبقى مجال لهذا الإشكال، لأنّ التغيّر الحادث في المستصحب لا يكون من مقوّماته بل يكون من خصوصياته فلا يمنع من صدق كونه هو هو وأنّه الّذي كان محكوماً بكذا، ويكفي هذا الاتّحاد العرفي لأن لا يدخل الحكم بالبقاء في إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، بل يرى العرف المستصحب باقياً على ما كان ويحكم ببقائه سواء كان موضوعاً لحكم أو كان نفس الحكم.
فإن قلت: هذا يجري في الموضوعات الخارجية والأحكام الشرعية الثابتة بالنقل دون الأحكام الشرعية الّتي مدركها العقل وكذا نفس حكم العقل، فلا مناص فيه من قبول الإشكال؛ لأنّ ملاك الحكم الشرعي الّذي مدركه حكم العقل هو ملاك مدركه والعقل لا يشكّ في حكمه فإن كان ملاكه في حال الشكّ باقياً يحكم ببقائه وإن لم يكن موجوداً لا يحكم به، فإذا لم يحكم العقل ببقاء حكمه كيف يحكم ببقاء الحكم الشرعيّ الّذي مدركه هذا الحكم العقلي؟
واُجيب عن هذا الإشكال بأنّ الملازمة بين الحكمين يكون في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، إذ من المحتمل أن يكون الحكم الشرعي المستكشف عن حكم العقل دائرته أوسع ممّا يكون بنظر العقل فلا تكون للخصوصية المفقودة عند الشرع دخل في موضوعيته للحكم وإن كان بنظر العقل في مقام الإثبات له دخل في حكمه.
وبعبارة اُخرى: العقل قد حكم به وهو كان واجداً للخصوصية الكذائية ولا يحكم به في حال فقدانه لها في مقام الإثبات ولكن لا يحكم بعدم الحكم ثبوتاً لفاقد
ص: 135
الخصوصية، فالحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل كالحكم الشرعي الثابت بالنقل لا فرق بينهما في الحكم ببقائه عند الشكّ فيه لطروّ بعض الحالات الّتي لا يراها العرف من مقوّماته إلّا أنّ الدليل على إحداهما العقل وعلى الآخر النقل.
وبالجملة: بعد ما لا يرى العرف التغيّر الّذي حصل فيه من مقوّماته ويحتمل سعة دائرة المستصحب في حكم الشرع وبقائه لا مانع من الحكم ببقائه كسائر الموارد، والله هو العالم.
ص: 136
اعلم أنّه قد استدلّ على حجّية الاستصحاب باستقرار بناء العقلاء على العمل به، وبالظنّ الحاصل من الثبوت في السابق((1)) وبالإجماع،((2)) وبالروايات الشريفة، فنقول:
أمّا الإجماع والظنّ المذكور فبطلان التمسّك بهما غنيّ عن البيان. أمّا الإجماع، فالمناقشة فيه ظاهرة صغروياً وكبروياً.
وأمّا الظنّ، فهو أيضاً مخدوش، بمنع الصغرى والكبرى؛ لأنّ مجرّد الثبوت في السابق لا يوجب الظنّ بالبقاء. وإن أوجبه فلم يقم دليل على حجّيته إلّا على القول بحجّية الظنّ المطلق.
وأمّا استقرار بناء العقلاء، فقد منع استقرار بنائهم عليه تعبّداً، بل لعلّه يكون رجاءً واحتياطاً أو ظنّاً كما قيل ولم يثبت رضا الشارع به. وعدم الردع وإن كان يكفي لذلك إلّا أنّه يكفي في الردع ما ورد في الكتاب والسنّة من النهي عن اتّباع غير العلم والعمل بالظنّ.
ولكن يمكن أن يقال بأنّ هذه النواهي لا تشمل مثل ما نحن فيه الّذي استقرّ عليه بناء العقلاء، بل ربما يقال: إنّ أمثال هذه البناءات لا تقبل الردع عنها ولا المنع منها كاستقرار سيرتهم على العمل بالاُصول اللفظية وبخبر الواحد، بل يمكن أن يقال
ص: 137
باستقرار عملهم على الثابت السابق، سيّما إذا كان مقتضياً للبقاء، كما قوّاه السيّد الاُستاذ. فالعقل والعقلاء يرون للمولى توبيخ عبده وذمّه إن ترك الأمر الّذي كان ثابتاً عليه إذا كان فيه اقتضاء البقاء.
وكيف كان، فالعمدة من الدليل هنا الأخبار فنجري الكلام فيها مستعيناً من الله تعالى، فنقول:
صحيحة زرارة الاُولى:
فمنها: صحيحة زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاُذن، فإذا نامت العين والاُذن والقلب فقد وجب الوضوء». قلت: فإن حُرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ ولكن ينقضه بيقين آخر».((1))
أقول: قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا» جزاء لقول زرارة: «فإن حُرّك...» أي لا يوجب ذلك (يعني تحريك شيء في جانبه وهو لا يعلم به) عليه الوضوء، ويبني عليه حتى يستيقن أنّه قد نام أي نامت عينه واُذنه وقلبه، فيجب عليه قبل هذا الاستيقان البناء على وضوئه. فإلى هنا يدلّ على وجوب البناء على وضوئه لو شكّ في تحقّق النوم الغالب على العين والاُذن والقلب بالخفقة أو الخفقتين، فلا تستفاد منه القاعدة الكلّية الّتي تعمّ سائر أبواب الفقه، بل سائر النواقض للوضوء.
ص: 138
ثم إنّ قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «وإلّا» يعني وإن لم يستيقن أنّه قد نام فجزاؤه مقدّر أي لا يجب عليه الوضوء، وهو محذوف معلوم من قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا» في جواب سؤاله «فإن حُرّك إلى...»، وقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) «فهو على يقين من وضوئه» بمنزلة العلّة للجزاء أي عدم وجوب الوضوء، فاُقيمت مقامه. وهي تكون الصغرى للكبرى الكلّية المذكورة بقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ». وقد جاء في القرآن الكريم والمحاورات العربية حذف الجزاء وذكر علّته مقامه، مثل قوله تعالى: ﴿إنْ يَسْ-رِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبلُ﴾.((1))
وعلى هذا البيان تتمّ دلالة الصحيح على حجّية الاستصحاب في جميع الأبواب.
فإن قلت: لماذا لا يكون قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «فهو على يقين من وضوئه» جزاءاً للشرط حتى يكون معناه: إن لم يستيقن أنّه قد نام فهو على يقين من وضوئه ولا ينقض يقينه بالوضوء بالشكّ فيه ولكن ينقضه بيقين آخر. وعلى هذا تنحصر دلالة الرواية على عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشكّ دون عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشكّ؟
قلت: مجرّد الاحتمال لا يكفي في صحّة استظهار المعنى من اللفظ. وظاهر الشرط كونه علّة للجزاء، وعدم يقينه بالنوم ليس علّة لكونه على يقين من وضوئه، بخلاف عدم وجوب الوضوء فإنّ علّته عدم اليقين بالنوم واليقين على كونه مع الوضوء.
لا يقال: من المحتمل كون الجزاء قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» وعليه أيضاً لا تستفاد منه القاعدة الكلّية ويختصّ بباب الوضوء.
فإنّه يقال: إنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر ومردود أيضاً، لمكان الواو في صدر هذه الجملة، فإنّه غير معهود تصدير الجزاء بالواو، لأنّه يوجب الاختلال في نظام الكلام.
ص: 139
فالوجه: ما ذكر من أنّ الشرط المستفاد من قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «وإلّا» إن لا يستيقن بالنوم، والجزاء مقدّر وهو «فلا يجب عليه الوضوء»، قام مقامه ما هو العلّة له وهو كونه «على يقين من وضوئه».
فإن قلت: هذا يتمّ لو كانت الألف واللام في قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» للجنس مع أنّ كونه مسبوقاً باليقين بالوضوء بقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «فهو على يقين من وضوئه» يقتضي كونها للعهد، وعلى هذا البيان أيضاً لا دلالة فيها على القاعدة الكلّية.
قلت: الظاهر من مثل هذه الجملة كون المراد منها أمراً ارتكازياً كلّياً غير المختصّ بمورد دون آخر. واختصاصه بخصوص مورد مستلزم للتعبّد الخاصّ وإدخال المورد تحته، وهو إنّما يصحّ إذا كان ذلك مبيّناً قبل ذلك معلوماً عند المخاطب.
هذا مضافاً إلى إمكان أن يقال: إنّ في قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «فهو على يقين من وضوئه» إن كان «من وضوئه» متعلّقاً باليقين يكون المراد من اليقين اليقين بالوضوء، فتختصّ القاعدة بالوضوء. وأمّا إن كان متعلّقاً بالظرف دون المظروف، بعبارة اُخرى متعلّقاً بقوله: «على يقين» يكون المعنى: أنّه من وضوئه على يقين لا من وضوئه الّذي تعلّق به اليقين على يقين، فتدلّ على حجّية اليقين مطلقاً، وعلى هذا يستقيم الاستدلال ولو كان اللام للعهد، وعليه لا مجال لإنكار دلالة الصحيحة على قاعدة الاستصحاب، فتدبّر.
وأمّا الإضمار الواقع في سنده فليس مضرّاً كما صرّح به أساتذة علم الحديث بعد ما كان مضمرها مثل زرارة الّذي لا يسأل في الشرعيات عن غير الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) سيّما بهذه الخصوصيات.
تذنيب: ظهر لك ظهور الرواية في الدلالة على القاعدة الجارية في جميع الأبواب.
ص: 140
وأمّا عند من يقصر دلالتها بباب الوضوء فإنّها بضميمة الروايات((1)) الواردة في موارد خاصّة اُخرى أيضاً تدلّ على القاعدة الكلّية، ويستفاد من الجميع أنّ الحكم غير مختصّ بباب دون باب وأنّ تلك الموارد المختلفة کلّها داخلة تحت القاعدة الكلّية الشاملة للجميع بملاك واحد.
ثم إنّه قد وقع الكلام بينهم في مقدار شمول هذه الرواية وغيرها من الروايات، فمثل الشيخ الأنصاري اختار عدم شمولها لما يكون منشأ الشكّ في البقاء الشكّ في اقتضاء المقتضي للبقاء، مثل الشكّ في بقاء السراج من جهة الشكّ في استعداده للبقاء. بخلاف ما إذا كان ذلك معلوماً وشكّ في حدوث الرافع مثل هبوب الرياح، أو في رافعية الموجود. فاختار اختصاصها بهذا وعدم جريانها في الشكّ المسبّب عن الشكّ في اقتضاء المقتضي.((2))
ص: 141
واختار صاحب الكفاية شمولها مطلقاً سواء كان الشكّ مسبّباً عن الشكّ في استعداد المقتضي، أو في حدوث الرافع أو في مانعية الموجود.((1))
وجه القول الأوّل: أنّ اليقين والشكّ إذا كانا متعلّقين بأمر في زمان واحد يصحّ النهي عن نقض اليقين بالشكّ، كما هو كذلك في الشكّ الساري. وأمّا إذا اختلف زمانهما وتعلّق اليقين بأمر في زمان ثمّ شكّ في بقائه في زمان متأخّر عنه فلا يصحّ النهي عن نقض اليقين بذلك الشكّ، فإنّه لم يكن للشاكّ يقين حتى لا ينقضه بالشكّ، وبالنسبة إلى الزمان المتقدّم فاليقين به على حاله لم يعرض بالنسبة إليه شكّ حتى ينهى عن نقض اليقين به بالشكّ، ففي الاستصحاب لا نقض لليقين المتقدّم حتى ينهى عنه بالشكّ المتأخّر عنه.
وبعبارة اُخرى: اليقين السابق لم يعرضه الشكّ والشكّ المتأخّر لم يعرض اليقين. فعلى هذا، حيث لا يصحّ إسناد النقض إلى اليقين لأنّ اليقين السابق في ظرف وجوده لا ينقض بالشكّ اللاحق، بل كما قلنا يصحّ النهي عن نقض اليقين بالشكّ إذا كانا متّحدين زماناً، فلابدّ وأن يكون النقض مسنداً إلى المتيقّن ويكون المتيقّن ما هو مستحكم ومستمرّ بذاته حتى يستحسن النهي عن نقضه بالشكّ في حدوث الرافع له، فلا يشمل الشكّ في اقتضاء المقتضي لأنّ النهي عن نقض اليقين فيه بالشكّ كأنّه بلا موضوع.
وجه القول الثاني: أنّه لا وجه للعدول عن ظاهر اللفظ الدالّ على إسناد النقض إلى اليقين، وحمل الحقيقة على المجاز، لأنّ اليقين أمر بنفسه متقن متين محكم وإن كان متعلّقه لم يكن بمبرم.
والإشكال بأنّه يشترط في إسناد نقض اليقين إلى الشكّ اتّحاد زمانهما وفي
ص: 142
الاستصحاب يكون الأمر بالعكس ويجب تعدّد زمانهما فلا ينقض اليقين في الزمان المتقدّم المتعلّق بأمر بالشكّ في بقائه في الزمان المتأخّر.
يمكن أن يجاب عنه أنّ ذلك يصحّ بغضّ النظر عن لحاظ الزمان بالنسبة إلى اليقين والشكّ فهما قد تعلّقا بأمر واحد أي وجود المتيقّن وإن كان اليقين تعلّق بوجوده الحدوثي والشكّ بوجوده البقائي ولكن ذلك لا ينفي تعلّقهما بذات وجود الشيء، وبهذا اللحاظ يصحّ في العرف أن يقال: لا تنقض يقينك بذات شيء بالشكّ في ذاته.
هذا، ولكن السيّد الاُستاذ(قدس سره) بعد ما بيّن وجه القولين أفاد بأنّ الصحيحة ظاهرة في حجّية الاستصحاب بالنسبة الى الشكّ فى الرافع - لا بالوجه الّذي أشرنا إليه بل - لأنّ ما اُخذ في الصحيحة موضوعاً للاستصحاب والحكم بعدم نقض اليقين بالشكّ فيه هو الرافع.
وبعبارة اُخرى: موضوع الكلام في الصحيحة الشكّ في الرافع لا الشكّ في أصل وجود المستصحب، وذلك لأنّ قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «وإلّا» يستفاد منه وإن لا يستيقن أنّه قد نام أي شكّ في حدوث الناقض فلا يجب عليه الوضوء، أي لا ينقض يقينه بعدم حدوث الناقض بالشكّ فيه؛ لا أنّه لا ينقض يقينه بالطهارة والوضوء الّتي فيها اقتضاء الدوام والاستمرار بالشكّ فيها.
وبعبارة اُخرى: الشكّ المفروض في الصحيحة شكّ في الناقض لا المنقوض فلا يشمل الشكّ في اقتضاء المقتضي.
ولعلّ الاختلاف وقع بين مثل الشيخ وصاحب الكفاية لأنّهما اعتبرا الشكّ الواقع في الحديث، الشكّ في الوضوء، فيجيء فيه ما ذكراه، دون الشكّ في النوم.
وحاصل الكلام أنّ ما تدلّ عليه الصحيحة حكم الشكّ في الرافع والناقض وأنّ الشكّ فيه لا يوجب رفع اليد عن اليقين السابق بوجوده، ولا تدلّ على أزيد من
ص: 143
ذلك كما إذا كان الشكّ في البقاء ناشئاً عن الشكّ في اقتضاء المستصحب للبقاء وعدمه، فتدبّر.
ولا يخفى عليك: أنّ ما ذكر هو الّذي يساعده الاعتبار، فإنّ للشك احتمالين، أحدهما: متعلّق بالوجود والآخر بالعدم، واحتمال العدم هو الّذي يكون ناقضاً للوجود وترتيب الأثر عليه يكون نقضاً ويكون النهي عن النقض وارداً عليه وهو احتمال الناقض، وأمّا احتمال وجوده فهو مؤكّد للبقاء، لا يكون ترتّب الأثر عليه نقضاً حتى يرد عليه النهي.
لا يقال: إنّ الشكّ في الرواية اعتبر مضافاً إلى الوضوء لا الناقض.
فإنّه يقال: هذا الاحتمال في حدّ نفسه ليس ببعيد إلّا أنّه خلاف ظاهر الرواية، فتأمّل.
إشارة:
هل المستفاد من الرواية إلغاء احتمال المانع بعد إحراز وجود المقتضي والمقتضى، وهو الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ في حدوث النوم بعد إحراز الوضوء المقتضي للطهارة وحصول مقتضاها به؟ وذلك هو مورد السؤال في الرواية، وهو القدر المتيقّن منها أو أنّها تدلّ على أعّم من ذلك فإذا احتمل وجود المانع حين حصول المقتضي وقبل حصول المقتضى - بالفتح - يحكم بإلغاء هذا الاحتمال؟ مثلاً على القول باقتضاء الملاقاة النجاسة ومانعية الكرّية عنها فيقال بنجاسة الماء لدلالة الصحيحة على إلغاء احتمال المانع مطلقاً، فتدلّ على القاعدة المسمّاة بقاعدة المقتضي والمانع القاضية بوجود المقتضى - بالفتح - بمجرّد وجود المقتضي، فلا يضرّ باعتبارها احتمال وجود المانع قبل حصول المقتضى - بالفتح - .
ص: 144
ومقتضى التحقيق: عدم دلالتها على إلغاء احتمال المانع مطلقاً، بل مقصورة على مورد السؤال وهو احتمال حدوث المانع بعد إحراز وجود المقتضى - بالفتح - كما هو الظاهر من الرواية. والله هو العالم.
ومنها: صحيحة اُخرى لزرارة المضمرة أيضاً على ما في التهذيب ولفظها:
قال: قلت له: «أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شيء من منيّ، فعلّمت أثره إلى أن اُصيب له الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثم إنّي ذكرت بعد ذلك». قال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «تعيد الصلاة وتغسله»، قلت: «فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته»؟ قال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «تغسله وتعيد»، قلت: «فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صلّيت فرأيت فيه»؟ قال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «تغسله ولا تعيد الصلاة»، قلت: لم ذلك؟ قال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً»، قلت: «فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله»؟ قال: «تغسل من ثوبك الناحية الّتي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك»، قلت: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه»؟ قال: «لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الّذي وقع في نفسك»، قلت: «إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة»؟ قال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ».((1))
ص: 145
ورواها الصدوق(قدس سره) في العلل بسند حسن مذكور فيها اسم الإمام المرويّ عنه(عَلَيْهِ السَّلاَمُ).((1))
الاُولى: في تقريب الاستدلال بها وهو ما ذكر في مقام الاستدلال بالصحيح السابق وأنّ المراد من الحديث بيان القاعدة الكلّية الارتكازية ودرج المورد المذكور فيه في تلك القاعدة، فلا حاجة إلى تكراره.
الثانية: أنّه جاء في المورد الأوّل من الرواية: «قلت: فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صليت فرأيت فيه»؟ قال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «تغسله ولا تعيد الصلاة»، قلت: «لم ذلك»؟ قال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً»، وهذه الفقرة تحتمل إحدى القاعدتين إمّا الاستصحاب وإمّا قاعدة اليقين.
بيان ذلك: أنّه معتبر في الاستصحاب تعدّد زمان المتيقّن وزمان المشكوك بمعنى لزوم كون زمان المشكوك متأخّراً عن زمان المتيقّن وإن كان نفس زمان اليقين والشكّ متّحداً، فإذا كان المراد من قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» اليقين السابق على ظنّ إصابة النجاسة يكون قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «فليس ينبغي لك...» دليلاً للاستصحاب.
ومن جانب آخر: يعتبر فى قاعدة اليقين اتّحاد زمان المتيقّن مع زمان المشكوك وإن كان زمان اليقين والشكّ فيهما متعدّداً. وبعبارة اُخرى: يعتبر فيها اتّحاد المتيقّن والمشكوك زماناً واختلاف اليقين والشكّ فيهما زماناً.
ص: 146
وبعبارة ثالثة: في قاعده اليقين لا يتعدّد المتيقّن والمشكوك بتعلّق اليقين بالمتيقّن في زمان والشكّ بالمشكوك في زمان آخر، بخلاف قاعدة الاستصحاب حيث يتعدّد المتيقّن والمشكوك بتعلّق اليقين بالمتيقّن في زمان وتعلّق الشكّ بالمشكوك في زمان آخر.
فالفقرة المذكورة من الحديث تنطبق على قاعدة اليقين إن كان المراد من قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» اليقين الحاصل بالفحص بعد الظنّ بالإصابة.
فعلى كون الفقرة ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب لا يزول - برؤية الدم بعد الصلاة - اليقين السابق على ظنّ إصابة النجاسة، بخلاف ما إذا كان المستفاد منها قاعدة اليقين، فاليقين الحاصل بالفحص بعد الظنّ بالإصابة يزول برؤية الدم بعد الصلاة لا محالة.
وكيف كان لا ريب في ظهور الفقرة في الاستصحاب. واحتمال كونها ناظرة إلى قاعدة اليقين وكون اليقين في قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» اليقين الحاصل بالفحص، ضعيف جدّاً.
الجهة الثالثة: قد استشكل الشيخ على الاستدلال بالفقرة لحجّية الاستصحاب، وحاصله: أنّ مفاده عدم جواز نقض اليقين بالشكّ كما هو الظاهر من قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) فيها: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً»، مع أنّ إعادة الصلاة بعد العلم بعدم وقوعها مع الطهارة المشروطة بها ليس نقضاً لليقين بالشكّ، بل هي عين نقض اليقين باليقين، فكيف يعلّل عدم وجوب الإعادة بأنّها نقض لليقين بالشكّ. نعم، يصحّ أن يعلّل به جواز الدخول في الصلاة لأنّه يلزم من عدم جوازه نقض اليقين بالشكّ، كما لا يخفى.((1))
واُجيب: بأنّه من الممكن أن يكون الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) أراد بيان ما هو شرط للصلاة في حال
ص: 147
الشكّ في الطهارة وأشار بقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لأنّك كنت...» أنّ الشرط في حال الشكّ إحراز الطهارة لا نفسها ووجودها الواقعي، فيجب أن يعمل به وهو مجزٍ عمّا هو عليه، وترك العمل به قبل كشف الخلاف، نقض لليقين بالشكّ. وبعبارة اُخرى: أنّه كان في حال العمل واجداً لما هو الشرط أي إحراز الطهارة واليقين بإجزاء ما أتى به، وبعد الانكشاف يشكّ في وجوب الإعادة ولا يجوز له نقض اليقين بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة بالشكّ فيه، والمفروض أنّه لا ينكشف بانكشاف عدم كونه مع الطهارة عدم كونه مع ما هو الشرط في الصلاة، لأنّ الشرط فيها هو إحراز الطهارة لا نفسها ووجودها الواقعي.((1))
فإن قلت: على هذا الفرض إذا كانت الطهارة المستصحبة ليست مشروطة بها الصلاة فليست هي بحكم شرعي ولا موضوعاً لحكم شرعي فما هو الوجه في صحّة هذا الاستصحاب وتسميته به على خلاف الاصطلاح؟
قلت: يمكن الجواب عن ذلك بأنّ مقتضى الأدلّة الأوّلية اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعية، والاكتفاء بإحرازها في حال الشكّ يكون بدلالة مثل هذه الرواية والجمع بينها وبين الأدلّة الأوّلية. ففي الحقيقة الطهارة بنفسها هي الشرط الواقعيّ الاقتضائي غير فعلي حتى في حال الشكّ، ولكن لا يمنع ذلك من استصحابها في ذلك الحال والحكم بعدم وجوب الإعادة بعد كشف الخلاف لكفاية إحرازها ولكون الشرط في هذا الحال أعمّ من الواقع وإحرازه، وإنّما اكتفي بالإحراز في مورد الشكّ لأجل التوسعة على المکلّفين وكثرة الابتلاء بالنجاسة والله هو العالم.
هذا إذا كان التعليل في الحديث الشريف بلحاظ حال الفراغ من الصلاة، وعليه يكون الاستصحاب ملحوظاً بنحو الموضوعية.
ص: 148
ويمكن أن يقال: إنّ التعليل كان بلحاظ حال الصلاة لأنّه في حال الصلاة يكون مأموراً بعدم الإعادة ومقتضى حرمة النقض في حال الصلاة مع كون الأمر الظاهري مقتضياً للإجزاء هو عدم وجوب الإعادة.
والقول بوجوب الإعادة بعد كشف الخلاف مستلزم لرفع اليد عن حرمة نقض اليقين بالشكّ الثابتة في حال الصلاة الّتي دلّ دليلها على الإجزاء مطلقاً. فراجع في ذلك إن شئت ما ذكرناه في بحث الإجزاء.
فإن قلت: إنّه لا فائدة لاستصحاب الطهارة بعد كفاية عدم العلم بالنجاسة في صحّة الصلاة.
قلت: يمكن أن يقال: إنّ ما تحقّق فيه الإجماع كفاية عدم سبق العلم بالنجاسة إذا أتى بالصلاة في حال الغفلة وعدم الالتفات، وأمّا إذا التفت فلابدّ من إحراز الطهارة علماً أو ما هو قائم مقامه شرعاً، والمفروض في السؤال هو صورة الالتفات، والله هو العالم بالصواب.
الجهة الرابعة: اعلم: أنّه إن تفصّي عن الإشكال المذكور في الجهة الثالثة بما ذكرنا فيها فهو، وأمّا إن بقي الإشكال على حاله فلا يوجب ذلك إشكالاً في دلالة الرواية على حجّية الاستصحاب؛ لأنّ أمرها دائر بين دلالتها على قاعدة الاستصحاب دون اليقين، أو على قاعدة اليقين فإن كان مدلولها الأوّل فهو، وإن كان الثاني فتدلّ على الاستصحاب بالأولوية والفحوى، لأنّ اليقين لمّا يكون حجّة في قاعدة اليقين مع سريان الشكّ إليه ولا يجوز رفع اليد عنه بالشكّ الساري إليه، فكيف أنت باليقين الثابت في حال الشكّ في المتيقّن! فتدبّر.
ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة: «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز
ص: 149
الثلاث، قام فأضاف إليها اُخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشكّ، ولا يُدخِل الشكّ في اليقين، ولا يُخلِّط أحدَهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويُتِمُّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».((1))
والاستدلال بها يبتني على كون المراد من اليقين اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، ومن الشكّ الشكّ في إتيانها.
وفيه:((2)) أنّ ذلك خلاف مذهب الإمامية الحقّ من وجوب الإتيان بالركعة المفصولة لا المتّصلة.
وما كتبه المقرّر الفاضل: بأنّه خلاف ظاهر الرواية، فإنّ الظاهر منها لزوم الإتيان بالعمل على نحو يحصل اليقين بالامتثال وعدم الاعتداد بالشكّ في الامتثال وفي مفروض السؤال يحصل العلم بالفراغ بالبناء على الرابعة وإتمام الصلاة ثم الإتيان بركعة مفصولة وبه يحصل الفراغ، فأين هذا من الاستصحاب؟((3))
ففيه: أنّه لم لا يحصل العلم بالفراغ بعد الإتيان بركعة متّصلة سيّما بمعونة دلالة الدليل؟ فالإشكال کلّه يرجع إلى أنّه على المذهب الحقّ لا يحصل بذلك الفراغ، وليس الإتيان بالركعة المتّصلة علاجاً للواقعة وإلّا فمقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بالرابعة وبقاء اشتغال الذمّة بها.
وهل يمكن الذبّ عن هذا الإشكال بأن يقال: إنّ أصل ترك الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة أو متّصلة خلاف الاستصحاب، والإتيان بها كذلك واجب بحكم
ص: 150
الاستصحاب، والرواية مطلقة في كونها مفصولة أو متّصلة فتقيّد بما دلّ على لزوم كونها مفصولة.
وأمّا الإشكال في الاستدلال بالرواية بأنّها من الأخبار الخاصّة الدالّة على خصوص ما وردت فيها، فلا يستفاد منها العموم، وإلغاء خصوصية المورد فيها غير واضح.
فيرد بأنّ إلغاء الخصوصية يكون بمناسبة ورود الحكم بالاستصحاب في موارد متعدّدة مختلفة، وانطباق قضية: «لا تنقض اليقين بالشكّ» على غير مورد، بل دلالة نفس القضيّة على عموم مفادها وعدم اختصاصها بمورد دون مورد.
ومنها: ما رواه الخصال عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، قال: «قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين».((1))
واحتمل ظهورها في قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان اليقين والشكّ الّذي هو في قاعدة اليقين، فلا يمكن اجتماعهما في زمان واحد.
ودعوى تداول هذا التعبير بالنسبة إلى الاستصحاب، لا يجعله ظاهراً في الاستصحاب.
وقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «فليمض على يقينه» ليس ظاهراً في اليقين الفعلي لو لم نقل بكونه ظاهراً في اليقين السابق الزائل بالشكّ الساري. ويمكن دعوى ظهوره في عدم رفع اليد عن اليقين مطلقاً سواء زال بالشكّ أو كان باقياً، فعلى کلّ حال يدلّ على الاستصحاب.
ومنها: خبر الصفّار عن عليّ بن محمد القاساني، قال: كتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية».((2))
ص: 151
وتقريب دلالته على الاستصحاب أنّ المراد من اليقين فيه اليقين بشعبان ومن الشكّ الشكّ في زواله بدخول شهر رمضان.
لا يقال: إنّ ذلك موقوف على كون شهر شعبان عنواناً واحداً وشيئاً فارداً يصدق عليه أنّه كان متيقّناً وشكّ في بقائه، وأمّا إذا لم يكن كذلك فليس في البين يقين سابق متعلّق بيوم شكّ فيه أنّه من شعبان أو شهر رمضان.
فإنّه يقال: لا يبعد دعوى كون شعبان عند العرف عنواناً واحداً تعلّق به اليقين وشكّ في بقائه.
اللّهمّ إلّا أن يدّعى أنّ الرجوع إلى الأخبار الواردة في يوم الشكّ يوجب القطع بأنّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنّه لا يجب الصوم والإمساك إلّا إذا حصل اليقين بدخول شهر رمضان فراجع في ذلك جامع أحاديث الشيعة.((1)) ولكن حكي عن السيّد الأصفهاني أنّه قال: إنّي راجعت الأخبار المنقولة في ذاك الباب فما وجدت في شيء منها شاهداً على كون متعلّق اليقين هو دخول شهر رمضان.
ومنها: قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في موثّقة عمّار: «كلّ شيء طاهر حتى تعلّم أنّه قذر...».((2))
وقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «الماء کلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر».((3))
وقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه».((4))
ص: 152
إعلم: أنّهم قد اختلفوا في مدلول هذه الأخبار، فمنهم من قال: بدلالتها على الاستصحاب بكون مدلول المغيّى الحكم الواقعي كالحلّية الواقعية أو الطهارة الواقعية، ومدلول الغاية استمرار الحكم إلى حصول العلم بطروّ ضدّه أو نقيضه، لا تحديد الموضوع.
ومنهم من قال: إنّ مفادها تأسيس القاعدتين الطهارة والحلّية في ما شكّ في طهارته أو حلّيّته من غير لحاظ الطهارة أو الحلّيّة السابقة، ودلالتها على ذلك تكون بالمغيّى والغاية جميعاً، والغاية تدلّ على تحديد الموضوع.
والقول الثالث: أن تكون في مقام تأسيس القاعدتين والاستصحاب جميعاً أيضاً بمجموع الغاية والمغيّى.
والقول الأوّل مختار صاحب الكفاية. والثاني مختار الشيخ والسيّد الاُستاذ(قدس سره).
ولا يخفى عليك: عدم صحّة القول الثالث عقلاً، لأنّه يوجب استعمال اللفظ في المعنيين والجمع بين اللحاظين؛ فإنّ المقصود بالقاعدتين هو إثبات الطهارة والحلّيّة لمشكوك الطهارة أو الحلّيّة، والاستصحاب استمرار الحكم الواقعي والطهارة الثابتة للموضوع بعنوانه الأوّلي، ولا جامع بين الاستصحاب وبين القاعدة الّتي موضوعها الشكّ في الحكم الواقعي. ولا يمكن اجتماع ثبوت الطهارة سابقاً باعتبار الاستصحاب، وعدم ثبوتها باعتبار الموضوع للقاعدة للزوم اجتماع النقيضين. وعلى ذلك يدور الأمر بين كون مفاد الأخبار القاعدتين أو الاستصحاب.
وأفاد السيّد الاُستاذ(قدس سره) أنّ الأخبار ظاهرة في القاعدتين، لأنّ الأخبار ظاهرة في تقييد أصل الحكم لا استمرارها. وبعبارة اُخرى: إنّها ظاهرة في تحديد الموضوع.
وذلك لأنّ إرادة الاستصحاب منها تحتاج إلى إضمار لفظ الاستمرار ولحاظ الثبوت واقعاً. ولأنّ الظاهر من الروايات أنّها بجميعها من صدرها وذيلها تكون لبيان حكم واحد لا أن يكون الصدر دالّا على حكم والذيل دالّا على حكم آخر، فتدبّر.
ص: 153
تذنيب:
لا يخفى عليك أن في قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «حتى تعلم أنّه قذر» احتمالان، أحدهما: أن يكون «قذر» فيه فعل الماضي. ثانيهما: أن يكون صفة مشبهة على وزن «فعل» بكسر العين كخشن.
ويقوّي الأوّل قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في ذيل الرواية: «فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم ليس عليك» وعلى ذلك، فالرواية تختصّ بالشبهة الموضوعية إذا كان الشكّ في القذارة العرضية وأمّا الشبهات الحكمية أو الموضوعية الّتي يكون الشكّ فيها في نجاسة الشيء أو طهارته بالذات كالمائع المردّد بين البول والماء لا يشملها الحديث، لدلالة قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «حتى تعلم أنّه قذر» بنحو الفعل الماضي على الشكّ في عروض النجاسة.
إنّ من الأقوال الّتي أحصيت في الاستصحاب((1)) القول بالتفصيل بين الأحكام الوضعية والتكليفية،((2)) وحيث لا فائدة في البحث عن سائرها - بعد ما استقرّ الاستدلال على حجّية الاستصحاب بالروايات من زمان والد شيخنا البهائي إلى زماننا هذا - اقتصرنا في الكلام عن هذه الأقوال المفصّلة بالبحث عن التفصيل المذكور، لأنّه بعد إطلاق الروايات لا مجال لتلك التفصيلات والأقوال.
وأمّا الأحكام الوضعية فلابدّ من الكلام عنها وأنّها هل تكون من الأحكام؟ وهل تنحصر مواردها ببعض العناوين؟ أو أنّها تشمل کلّ ما يكون بالوضع؟ وهل تشمل
ص: 154
ما كان مستقلّا بالوضع؟ أو يعمّ ما ينتزع من التكليف؟ وعلى کلّ حال ينبغي البحث عنها، والله هو الهادي إلى الصواب، فنقول: الكلام فيه يقع في جهات:
اختلفت کلماتهم في تعريف الحكم، فعن بعضهم تعريفه: بأنّه خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المکلّفين من حيث الاقتضاء والتخيير.
وهذا لا يشمل الأحكام الوضعية ويختصّ بالأحكام الخمسة التكليفية، ولذا زادوا عليه «الوضع».
ومع ذلك اُورد على هذا التعريف: بأنّ الحكم لا ينحصر في الخطابات اللفظية بل يعمّها والأفعال الصادرة عن الشارع في مقام بيان الحكم وإنشائه مثل الوضوءات والصلوات البيانية.
هذا مضافاً إلى أنّ الحكم ليس ظاهر الخطاب، بل الخطاب دالّ عليه والحكم مدلوله.
ولعلّ التعريف الأسدّ والأخصر ما حكى المقرّر الفاضل عن السيّد الاُستاذ(قدس سره) وهو: أنّ الحكم ما جعله الشارع بالجعل الاستقلالي أو التبعي.((1)) وهذا التعريف جامع شامل للحكم التكليفي والحكم الوضعي.
هل الأحكام الوضعية مجعولة بالجعل الاستقلالي بتعلّق الجعل بنفس عناوينها، أو
ص: 155
مجعولة بالجعل التبعي بتبع جعل الأحكام التكليفية ومنتزعة عنها؟((1))
وليس المراد كونها منتزعة من جعل نفس عناوينها والخطاب المتعلّق بها، فإنّ الأحكام التكليفية أيضاً كذلك منتزعة من جعل نفس عناوينها والخطابات المتعلّق بها كقوله تعالى: ﴿أَقيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فإنّ حكم وجوب الصلاة منتزع منه. بل المراد من كونها منتزعة انتزاعها من الأحكام التكليفية وأنّها مجعولة بالجعل التبعي.
وإذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الوضع على أنحاء:
فمنها: ما لا يقبل الجعل التشريعي. وعدّه من أنحاء الوضع مبنيّ على المسامحة وباعتبار عدم إمكان وقوع الوضع بالنسبة إليه كما يأتي.
ومنها: ما يقبل الجعل التبعي دون الاستقلالي.
ومنها: ما يقبل التبعي كما يقبل الاستقلالي.
فالأوّل منها: كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب للتكليف وشرطه ومانعه ورافعه، فهذا القسم خارج عن وصول يد التشريع إليه لا مستقلّا؛ لأنّ هذه العناوين تنتزع من ذوات ما هو السبب أو الشرط أو المانع أو الرافع، وهذه اُمور واقعية موجودة في الخارج لا تنفكّ عنها خصوصياتها وما تنتزع عنها من العناوين.
ولا تبعاً للتكليف، لتأخّر التكليف عنها كتأخّر وجود کلّ شيء عن سببه وشرطه ومانعه، ولتهافت انتزاع رافع الشيء عن نفسه.
وبالجملة: هذه العناوين ليست مجعولة أصلاً، لا تبعاً ولا استقلالاً.
ص: 156
فهذا القسم خارج عن البحث بأنّه الأحكام الوضعية هل هي مجعولة بالاستقلال أو تبعاً للأحكام التكليفية، لأنّ مثل هذا البحث يأتي فيما تناله يد الجعل التشريعي، فما ليس كذلك يكون خارجاً عن البحث ولا يطلق عليه الحكم فضلاً عن كونه تكليفياً أو وضعياً.
وأمّا الثاني: فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء للمكلّف به وشرطه ومانعه. فهو - على ما في الكفاية - ليس مجعولاً بنفسه؛ لأنّ اتّصاف الشيء بهذه الاُمور لا يعتبر قبل تعلّق الأمر به فلا يكون الاتّصاف بها إلّا باعتبار كونها مأخوذة في متعلّق الأمر، فتكون مجعولة بتبع الأمر والتكليف.((1))
وأورد عليه السيّد الاُستاذ(قدس سره) كما في الحاشية: بأنّ الجزء مثلاً لا يكون جزءاً من المأمور به قبل تعلّق الأمر به، ولكنّه جزء لما تعلّق به الأمر، وما هو متقدّم على الأمر ويتوقّف عليه الأمر فهو جزء للصلاة الّتي ينطبق عليه عنوان المأمور به بعد تعلّق الأمر بها لا يمكن أن يكون متأخّراً عن الأمر به، فاعتبار السورة - مثلاً - جزءاً للصلاة مجعول مستقلّ قبل تعلّق الأمر بها، وباعتبار تعلّق الأمر بها يكون جزءاً للمأمور به. وعلى هذا، يصحّ أن يقال: إنّ الجزئية مجعولة بنفسها لا يمكن أن تكون مجعولة بالتبع، للزوم تأخّر ما حقّه التقدّم وتقدّم ما حقّه التأخّر، فتدبّر.
وأمّا الثالث: فاعلم: أنّ في مثل القضاء والحجّية والنيابة والحرّية والرقّية والزوجية والملكية وغيرها من الاعتبارات يمكن الجعل التشريعي، وليس هنا ما يدلّ على عدم إمكانه كما كان في القسم الأوّل، بل وقوعه في الخارج أيضاً ممّا لا ريب فيه.
وإنّما الكلام في أنّ جعل هذه العناوين يكون بالاستقلال، أو هي مجعولات بتبع
ص: 157
جعل الأحكام، أو منتزع عن الأحكام؟ والتحقيق أنّها منشئات بأنفسها. فولاية الولي نشأت بنفسها ليست منتزعة عن جواز تصرّفاته ولا بتبع الحكم بجوازه. وكذا مثل الحرّية منشأة بإنشاء المولى، والزوجية بالعقد، والملكية أيضاً بالعقد. فربما تتحقّق هذه العناوين ولم تتحقّق الأحكام. وربما تتحقّق الأحكام ولم تتحقّق هذه العناوين.
وبالجملة: فهذه الولاية الكبرى والإمامة العظمى الثابتة للنبيّ والوليّ ناشئة بنفس إنشائها من الله تعالى، ولا شكّ في أنّ جعلها للنبيّ والوليّ من جانبه تعالى جعل مستقلّ ليس منتزعاً من الأحكام التكليفية وجواز تصرّفهما في الاُمور، بل الأمر هنا بالعكس ويكون التكليف تابعاً للوضع، هذا.
قال صاحب الكفاية هنا: وهمٌ ودفع،((1)) وكأنّه أراد به دفع الإشكال عمّن يقول بأنّ الملكية من الاعتبارات المجعولة بالإنشاء الّتي تكون على اصطلاح أهل المعقول من خارج المحمول، لأنّه ليس بحذائه شيء في الخارج مع أنّ الملك باصطلاحهم من المحمول بالضميمة وهو لا يتحصّل بالإنشاء بل بأسباب خارجية، كالتعمّم والتقمّص والتنعّل.
وحاصل دفعه: أنّ الملك مشترك بين الملكية الحاصلة بالإنشاء، وهو غير الملك الحاصل بتلك الأسباب المصطلح عند أهل المعقول.((2))
ص: 158
وبعبارة اُخرى للملك معنيان بأحدهما يكون من خارج المحمول وهو: كونه مجعولاً بمجرّد الإنشاء والاعتبار. وبالآخر يكون من المحمولات بالضميمة كالتعمّم والتقمّص والتلبّس. ولا ريب في أنَّ إطلاق الملك على الأوّل حسب اللغة وعدّه من خارج المحمول حسب الاصطلاح وعلى الثاني يكون على حسب الاصطلاح فقط.
وهذا إشكال على أهل المعقول حيث اختصّوا الملك الّذي ظاهر معناه اللغوي هو ما يوجد بالإنشاء بما يوجد بأسباب اُخرى بحيث يخرج منه ما هو بأصل المعنى اللغوي الملك.
وكيف كان، فالمعنى والمراد لا يختلف باختلاف الاصطلاحات، فالملكية منشأة بالاستقلال وإن لم تكن من الملك الّذي اصطلحه من يسمّى بالاصطلاح من أهل المعقول، فالحقيقة لا تتغيّر ولا تتبدّل بالاصطلاح.
وصاحب الكفاية كأنّه أراد الدفع عن الاُصوليين وأنّهم لم يطلقوا الملك في غير موضعه، ولم يدافع عن أهل المعقول بأنّهم أطلقوا الملك في غير موضعه، كأنّه يرى أنّه يجب على الجميع متابعة اصطلاحات أهل المعقول.
ونعم ما قال الشيخ صاحب الذريعة في توصيف كفاية الاُصول: وقد أدخل المسائل الفلسفية في الاُصول أكثر ممّن قبله من مؤلّفي الرسائل والفصول والقوانين.((1)) انتهى. والله هو العاصم، وشكّر الله مساعيه ومساعي الجميع.
هذا، وبعد ما ذكرناه من التفصيل في حال الوضع فاعلم: أنّه لا مجال للاستصحاب إذا كان على النحو الأوّل الّذي قلنا: إنّه خارج من أقسام الوضع، وذلك لأنّه من الواجب أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا حكم شرعي، والسببية والشرطية والمانعية للتكليف ليست من ذلك.
ص: 159
وترتّب التكليف - الّذي هو حكم شرعيّ - عليها لا يجزي، لأنّه ليس من ترتّب الحكم على موضوعه بل يكون من ترتّب المعلول على علّته وهو ترتّب عقلي لا شرعي.
وأفاد السيّد الاُستاذ بأنّ ذلك يتمّ إن كان الاستصحاب جارياً في نفس العلّة.
أمّا إذا كان جارياً في علّية العلّة فيجوز إجراء الاستصحاب فيه، وذلك لأنّ حقيقة علّية شيء لشيء آخر إصداره إيّاه وصدور المعلول منه، وكلّ منهما بحسب الحقيقة عين الآخر كالإيجاد والوجود وإن كانا متغايرين بحسب المفهوم، فاستصحاب العلّيّة حقيقة ترجع إلى استصحاب المعلول أي نفس التكليف، فلا مانع من استصحابه لأنّه حكم شرعي، فتأمّل فإنّ الحكم بالاستصحاب على وجود أركانه كموضوعه على هذه الدقائق البعيدة من الأذهان والقول بشمول الأدلّة له ليس خالياً من الإشكال، كما قيل مثل ذلك في استصحاب العدم الأزلي.
ثم إنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل فإنّه يصحّ التعبّد به في حال الشكّ، وكذا في ما كان مجعولاً بالتبع، فإنّ أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بالتبع. نعم، لو كان متبوعه مجرى الاستصحاب يكفي جريان الاستصحاب فيه كما هو الشأن في كلّ شكّ مسبّبي، فلا محلّ لإجراء الاستصحاب فيه إذا كان جارياً في سببه، والله هو العالم.
ص: 160
المعتبر في الاستصحاب فعليّة الشكّ واليقين، فلا يجري في حقّ الغافل، فمن أحدث وغفل ولم يحدث له شكّ في بقاء حدثه وصلّى لا يجري استصحاب الحدث في حقّه بشكّه بعد الصلاة في أنّه تطهّر قبل الصلاة أم صلّى محدثاً بل يحكم بصحّة صلاته لقاعدة الفراغ. بخلاف من أحدث والتفت وشكّ في الطهارة فإنّ الاستصحاب يجري في حقّه، فإن لم يتطهّر وغفل وصلّى يحكم ببطلان صلاته.
نعم، يمكن إجراء الكلام فيما إذا شكّ في الطهارة وبنى على الحدث بحكم الاستصحاب وغفل عن كونه محدثاً وصلّى ثم بعد الصلاة شكّ في أنّه تطهّر وصلّى أم صلّى مع الحدث، فهل في هذه الصورة تجري قاعدة الفراغ كالصورة الاُولى، لأنّه لا فرق في الغفلة عن الحدث بين ما إذا كان معلوماً بالوجدان أو بالأصل؟ أو أنّ المسألة تبتني على تحقيق مورد قاعدة اليقين؟ فالكلام فيه يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في أنّ قاعدة الفراغ هل تختصّ بما إذا حدث الشكّ بعد الفراغ من العمل ولم يكن مسبوقاً بالشكّ قبل العمل، أو تعمّ ما إذا كان مسبوقاً بالشكّ قبل العمل وإن غفل عنه حين العمل؟
حكى المقرّر الفاضل عن السيّد الاُستاذ: أنّه لا إطلاق لروايات باب قاعدة الفراغ
ص: 161
تشمل الصورة الثانية، بل تكون ظاهرة في الشكّ الحادث بعد العمل مثل قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «كلّما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامض فيه» فإنّ قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «فذكرته تذكّراً» ظاهر في حدوث الشكّ بعد العمل. ووجه ذلك الظهور أيضاً القرينة المغروسة في أذهان أهل العرف من أنّ من عمل عملاً إنّما يعمله جامعاً لأجزائه وشرائطه فلا يترك شيئاً منه إلّا لعروض غفلة، ومع الشكّ والترديد لا يتمشّى منه العمل، وإذا حصل له الشكّ بعد العمل لا يعتني به، وهذه قرينة مانعة عن الإطلاق.((1))
أقول: فيه: أنّ في الحدث الثابت بالأصل أيضاً إذا غفل عنه يحكم بكون العمل واقعاً جامعاً للشرائط لمغروسية ما ذكر في الأذهان.
المقام الثاني: في أنّه على فرض شمول أدلّة القاعدة ما إذا كان منشأ الشكّ سابقاً على العمل، هل يجري الاستصحاب في حقّ من أحدث ثم شكّ في رفعه وغفل وصلّى ثم شكّ بعد الصلاة في صحّتها باعتبار الشكّ السابق على الصلاة، أو تجري في حقّه قاعدة الفراغ؟
قد أفاد السيّد الاُستاذ(قدس سره): أنّ حكومة القاعدة على الاستصحاب إنّما تكون إذا كان مجراه بعد العمل باعتبار الشكّ الطارئ بعده. وأمّا إذا كان مجراه الشكّ السابق على العمل فيجري الاستصحاب دون القاعدة، لأنّ مجراها بعد العمل.
وبالجملة: في الشكّ الحادث بعد الفراغ إذا لم يكن مسبّباً من الشكّ السابق على العمل فقاعدة الفراغ هي الحاكمة على الاستصحاب فلا يجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الصلاة. بخلاف الشكّ السابق، فإنّه مجرى الاستصحاب ولا تجري فيه القاعدة.((2))
ص: 162
ولكن بعد ذلك يمكن أن يقال: إذا كان منشأ القاعدة الارتكاز المذكور فالغفلة عن الحدث المعلوم بالأصل أولى بجريان القاعدة فيه من الغفلة عن الحدث المعلوم بالوجدان.
وبعبارة اُخرى: الغفلة عن الحدث المشكوك فيه - وإن كان مجری الأصل - أولى بإجراء القاعدة فيه وعدم الاعتناء به من الحدث المعلوم بالوجدان. اللّهمّ إلّا أن يكون ذلك بالتعبّد المحض. والله هو العالم.
قد اُشكل على جريان الاستصحاب في الأحكام الّتي قامت الأمارات والطرق المعتبرة على ثبوتها، فاُحرز حدوثها بها لا بالوجدان، وشكّ في بقائها بعد البناء على حدوثها؛ وذلك لعدم اليقين بالحدوث، بل وعدم الشكّ في البقاء لأنّه فرع اليقين بالحدوث، والمعتبر في الاستصحاب اليقين بالحدوث والشكّ في بقاء المتيقّن.
وأفاد السيّد الاُستاذ(قدس سره) هنا:((1)) أنّ ما يمكن أن يؤخذ في موضوع الاستصحاب والتعبّد بالبقاء في مقام الثبوت والواقع إمّا أن يكون نفس ثبوت الشيء واقعاً وإن لم يكن ثبوته محرزاً، فصحّة جريان الاستصحاب واقعاً يدور مدار الثبوت واقعاً وإن كان جريانه بحسب الظاهر لعلّه يحتاج إلى طريق محرز وبدونه لا يجري. نعم، يترتّب عليه صحّة جريان الاستصحاب فعلاً على تقدير الثبوت فيما كان هناك أثر شرعيّ مترتّب على هذا العنوان، وهذا هو الوجه الّذي اختاره المحقق الخراساني(قدس سره) في مقام الإثبات.((2))
ص: 163
ووجهه: أنّ التعبّد والتنزيل شرعاً يكون في البقاء لا في الحدوث فيكفي الشكّ في البقاء على تقدير الثبوت، فيتعبّد به على هذا التقدير فيترتّب عليه ما يترتّب على البناء على ثبوته.
وإمّا يكون المأخوذ في موضوع الاستصحاب نفس ثبوت الشيء إذا كان محرزاً باليقين أو الأمارة، فيجري استصحابه على فرض إحرازه بأيّ محرز سواء كان اليقين أو الأمارة.
فعلى هذين الوجهين لا مانع من جريان الاستصحاب في الأحكام الثابتة بالأمارة.
وهنا وجه ثالث: وهو أن يكون موضوع الاستصحاب الشيء المحرز بخصوص اليقين، فيجري الاستصحاب إذا كان هو محرزاً باليقين دون الأمارات. هذا کلّه في مقام الثبوت.
وأمّا في مقام الإثبات فالّذي استظهره صاحب الكفاية هو: أنّ اليقين في الروايات مأخوذ من حيث كاشفيته وطريقيته لا لموضوعيته وبما هو هو، وعلى ذلك يجري الاستصحاب في موارد الأمارات ومؤدّاها كما يجري فيما تعلّق به اليقين.((1))
ولكن ردّ عليه السيّد الاُستاذ(قدس سره) بكونه خلاف الظاهر من الأخبار لظهورها في أنّ اليقين بما هو يقين مأخوذ في الحكم. ومع الغضّ عن ذلك لا ظهور لها فيما ذكر. فلا يحتجّ بها على أحد الاحتمالين لإجمال الروايات.
نعم، القدر المتيقّن منها صورة اليقين، إلّا أن يدّعى القطع بعدم خصوصية اليقين وأنّه جاء في الروايات لمحض الكاشفية وباعتبار كونه أحد المحرزات.
والحاصل: أنّ السيّد الاُستاذ(قدس سره) كأنّه استقرّ نظره على أنّ الحكم بجريان الاستصحاب في موارد الأمارات يحتاج إلى ارتكاب خلاف الظاهر، ولذا قال: إنّ الاحتياج بارتكاب مخالفة الظاهر مبنيّ على كون مدلول الأخبار حجّية الاستصحاب، كما هو كذلك عند الشيخ وصاحب الكفاية. أمّا بناءً على كون مدلولها حجّية قاعدة المقتضي والمانع فلا يحتاج شمول الأخبار لموارد الأمارات من ارتكاب خلاف الظاهر
ص: 164
وحمل اليقين على أعمّ منه وسائر المحرزات، وذلك لاعتبار اتّحاد القضية المشكوكة والمتيقّنة في الاستصحاب دون القاعدة.
فإذا قامت البيّنة على عدالة زيد يوم الخميس وشككنا فيها يوم الجمعة لا يجري استصحاب عدالته في يوم الجمعة، لأنّ عدالته لم تكن متيقّنة يوم الخميس بل قامت الحجّة على ثبوتها فيه، وقيامها عليه كذلك تجعلها مظنون الوجود - بالظنّ المعتبر - لا متيقّن الوجود. واليقين بحجّية البيّنة لا يكفي في تحقّق أركان الاستصحاب، فإنّه تعلّق بغير ما تعلّق به الشكّ وهو عدالة زيد.
وهذا بخلاف القاعدة، فإنّ عليها يبنى على بقاء عدالته، فإنّ مقتضى حجّية البيّنة - الّتي تعلّق بها اليقين - ترتّب جميع آثار العدالة الواقعية، ولا ترفع اليد عنها بالشكّ في حدوث ما يزيل به عدالته، والقضية المشكوكة فيها غير المتيقّنة. وهذا عين کلام المقرّر عنه(رحمه الله).
وبالجملة: شمول أخبار الباب لمثل الأحكام الثابتة بالأمارات غير القطعية بناءً على حملها على الاستصحاب مشكل جدّاً، لما استظهرناه من الأخبار أنّ اليقين مأخوذ من حيث هو هو لا من حيث هو كاشف... إلخ.((1))
أقول: لا إشكال في ما ذكر من الدعوى، واستظهار عدم خصوصية اليقين. مضافاً إلى إمكان إلغاء هذه الخصوصية في مثل هذه الاُمور والقواعد الجامعة المفيدة.((2))
ص: 165
ص: 166
المستصحب إن كان حكماً أو موضوعاً جزئياً فلا ريب في جواز استصحابه.
وإن كان أمراً کلّياً فإمّا أن يكون الشكّ في بقائه من جهة الشكّ في بقاء الفرد الّذي يكون الكلّي موجوداً في ضمنه، فلا إشكال في استصحاب الكلّي لترتيب الأثر الثابت له. كما لا إشكال في استصحاب الفرد المشكوك بقاؤه الّذي كان الكلّي موجوداً في ضمنه للأثر الشرعي المترتّب على نفس الفرد. وهذا مثل الشكّ في الحيوان باعتبار الشكّ في بقاء الفيل مثلاً بشخصه.
ولكن لا يخفى عليك: أنّ تسمية هذا بالاستصحاب الكلّي مبنيّ على المسامحة، لأنّ وجود الكلّي الطبيعي عين وجود فرده واستصحاب الفرد يغني عن استصحابه. فما قال بعضهم من عدم جواز استصحاب الفرد لإثبات الأمر المترتّب على الكلّي إلّا على القول بالاُصول المثبتة، كأنّه ليس في محلّه.
والقسم الثاني: من استصحاب الكلّي ما يكون الشكّ في بقاء الكلّي من جهة تردّد وجوده بين ما يكون مقطوع الزوال وما يكون مشكوك البقاء أو مقطوع البقاء. وفي هذا يجري أيضاً استصحاب الكلّي كالحيوان المردّد وجوده في ضمن البقّ أو حيوان مشكوك البقاء أو مقطوع البقاء كالفيل. والتردّد المذكور لا يمنع من استصحاب الكلّي المردّد وجوده بين الحيوانين المفروضين لتمامية أركان الاستصحاب.
وقد اُشكل على هذا الاستصحاب: بأنّ الشكّ في بقاء ذلك الكلّي المردّد بين الخاصيّن مسبّب عن الشكّ في حدوث الخاصّ المتيقّن البقاء على تقدير حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بالأصل، ومع جريانه في السبب لا يبقى مجال لإجرائه في المسببّ.
وفيه: أنّ الشكّ في بقاء الكلّي وارتفاعه ليس من لوازم حدوث الخاصّ - أي الفرد الطويل - حتى يكون محكوماً بالعدم بحكم الأصل، بل يكون من لوازم كون الحادث
ص: 167
المتيقّن وجوده هل هو المتيقّن الارتفاع أو المتيقّن البقاء؟ فيكون الشكّ في خصوصية الحادث وهذه ليس مسبوقة بالعدم حتى تستصحب.
وأيضاً يجاب عن هذا الإشكال: بأنّه يكون بناءً على ثبوت الملازمة بين وجود الفرد والكلّي حتى يكون الأصل في الفرد مغنياً عن إجراء الأصل في الکلّي، ولكنّ التحقيق أنّ الكلّي موجود بعين وجود الفرد كما قيل: «الحقّ: أنّ وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه»، وعلى هذا يسقط التوهّم المذكور من إجراء الأصل في السبب ونفيه في المسبب.
ويجاب ثالثاً: على فرض تسليم الملازمة بين الكلّي والفرد، ولكن إجراء الأصل في السبب يغني عنه في المسبّب إذا كان بينهما ملازمة شرعية لا عقلية ولا عادية، واللزوم بين الكلّي والفرد عقلي، فلا نستغني بإجراء الأصل فيه عن الأصل في الكلّي.((1))
هذا، وقد أورد السيّد الاُستاذ على اُستاذه صاحب الكفاية بأنّ نظر المستشكل في جريان أصالة عدم حدوث الخاصّ ليس إلى نفي الكلّي حتى يقال: إنّه من لوازم الحادث لا الحدوث، بل نظره إلى ما هو الأثر للكلّي شرعاً، وأنّ نفي الخاصّ يكفي في نفي الأثر الشرعيّ المرتّب على الكلّي لخفاء الواسطة، وأنّ العرف يرى الأثر مرتّباً على الفرد لا على الكلّي الّذي هو في ضمن الفرد. وقولكم: إنّ الكلّي عين الفرد، ووجوده وجود الفرد مؤيِّد لذلك. فعلى هذا، يكفي في عدم ترتّب الأثر الّذي هو للكلّي لا الكلّي نفي الفرد.
وعلى ذلك، لا يبقى مجال للجواب الثالث من أنّ ترتّب آثار الكلّي على الخاصّ عقلي لا شرعي، فإنّ العرف يرى الآثار آثاراً للفرد.
ص: 168
ثم إنّه يمكن أن يقال في قوله في دفع التوهّم: «إنّ بقاء الكلّي وارتفاعه ليسا من لوازم الحدوث بل من لوازم الحادث»: إنّه وإن كان كذلك، لكن لا يمنع من جريان الأصل في السبب بأن يقال: إنّ المراد من اللازم وإن كان من لوازم الحادث إلّا أنّ الكلّي في الخاصّ أيضاً يكون معلولاً له والجنس يكون معلولاً للصورة النوعية. وعلى هذا، يكون الشكّ في بقاء الكلّي فيما إذا تردّد بين كونه مقطوع الزوال أو مقطوع البقاء كالحيوان المردّد بين البقّ والفيل مسبّباً عن الشكّ في أنّه هل وجد الفيل أم لا؟ والأصل عدمه. وعلى ذلك کلّه لا يبقى مجال لاستصحاب الكلّي.
ولكن بعد ذلك يمكن أن يقال: إنّ عدم الكلّي ليس مركّباً من أعدام نظير المركّبات الوجودية حتى يحرز بعض أجزائها بالأصل وبعضها بالوجدان، بل عدم الكلّي أمر بسيط ينتقض بوجود فرد منه، فلا يقال: إنّه معدوم باعتبار عدم سائر أفراده. وعلى هذا، لا يثبت عدم الكلّي باستصحاب عدم الفرد المشكوك حتى يمنع من استصحاب وجود الكلّي.((1))
أقول: لا کلام في أنّه باستصحاب عدم بعض أفراد الكلّي لا يثبت نفي الكلّي ولا يحكم بعدمه به، ولكن إذا كان سائر أفراده غير الفرد المشكوك وجوده معلوم العدم لم لا يحكم باستصحاب عدم المشكوك بعدم الكلّي؟ كما يقال في المركّبات الوجودية بوجود المركّب بإثبات بعض أجزائه بالأصل والبعض الآخر بالوجدان.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك لا يثبت عدم الكلّي إلّا على القول بالأصل المثبت، وهذا كما إذا كان لمجموع المركّب بعنوانه المجموعي الواقعي حكم، فإنّه يمكن أن يقال: إنّ باستصحاب وجود بعض الأجزاء لا يثبت العنوان الّذي هو موضوع الحكم إلّا بالأصل المثبت.
ص: 169
هذا کلّه في القسم الثاني من استصحاب الكلّي.
وهنا قسمان آخران الثالث والرابع.
القسم الثالث: وهو ما إذا شكّ في بقاء الكلّي لاحتمال وجود فرد آخر مقارناً مع وجود الفرد الّذي نقطع بعدمه في آن بعد ذلك.
ولا ريب في عدم جريان استصحاب الكلّي بعد القطع بعدم ما هو كنّا نقطع بوجوده لاحتمال وجود فرد آخر منه مقارناً لوجوده، وذلك لفقد أركان الاستصحاب من اتّحاد القضية المشكوكة والمتيقّنة؛ لأنّ المتيقّن السابق مقطوع الزوال في الآن الثاني، والمشكوك مشكوك الوجود من أوّل وجوده، فليس هنا شكّ في البقاء بل الشكّ في الحدوث.
القسم الرابع: وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي من جهة احتمال فرد آخر مقارناً لارتفاع الفرد الّذي نقطع بارتفاعه.
وحكم هذا أيضاً كسابقه لا يجري فيه الاستصحاب، كما لا يخفى.((1))
ثم إنّه لا يخفى عليك أنّ ما ذكر إنّما يكون في الكلّي إذا كان متواطئاً((2)) وأمّا في الكلّي المشكّك((3)) فلا مانع من استصحابه إذا شكّ في بقائه من جهة الشكّ في ارتفاعه أو تبدّل مرتبته الشديدة مثلاً بالمرتبة الضعيفة كالسواد الشديد إذا شكّ في ارتفاعه أو تبدّله إلى الضعيف، ففي الحقيقة هذا من القسم الأوّل.
وعلى ما هو مقتضى التحقيق في الفرق بين الإيجاب والاستحباب، والحرمة والكراهة من كونه بشدّة الطلب وضعفه، أو شدّة الزجر وضعفه، يمكن أن يقال
ص: 170
بصحّة استصحاب المطلوبية والرجحان، أو المزجورية والمرجوحية إذا شكّ في بقاء کلّ واحد منهما بعد العلم بارتفاع الوجوب أو الحرمة.
لا يقال: إنّ العرف يرى الإيجاب والاستحباب من المتباينين، ولا يرى الشكّ في الاستحباب بعد رفع الإيجاب من اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة، لاختلاف موضوعهما وإن كان كذلك بحسب الدقّة العقلية.
فإنّه يقال: هذا مسامحة من العرف، ولعلّ منشأ مسامحتهم في هذا النظر ما قرع سمعهم من الفقهاء من عدّ الأحكام الخمسة فتوهّموا تباينها، وبعد الالتفات إلى عدم صحّة منشأ توهّمهم وأنّ الفرق بينها يكون بالشدّة والضعف يرون نفي الرجحان أو المرجوحية من نقض اليقين بالشكّ، فأفهم وتأمّل.
لا شبهة في جريان الاستصحاب في الاُمور القارّة وهي الاُمور الّتي تجتمع أجزاؤها بعضها مع بعض في الوجود.
وأمّا التدريجية، وهي: ما ليس كذلك كالزمان والزمانيات مثل: الحركة والتكلّم، وما اُخذ الزمان قیداً له كالصوم المقيّد بالنهار.((1))
فإن كان الأمر التدريجي نفس الزمان أو من الزمانيات كالحركة والتكلّم، فكما أفاد في الكفاية:((2)) الظاهر جريان الاستصحاب فيه وإن كان ينصرم وجودها ولا يتحقّق منه جزء إلّا بعد انصرام الجزء الأوّل ولكن ما لم يتخلّل عدم في البين لا تنثلم أركان
ص: 171
الاستصحاب به، كنفس الزمان. بل وإن تخلّل العدم ولا يخلّ بالاتّصال العرفي والوحدة العرفية مثل التكلّم. لصدق النقض والبقاء فيه عرفاً.
مضافاً((1)) إلى أنّه لو فرض في الاستصحاب بقاء المستصحب بالدقّة العقلية يمكن تحقّقه في الحركة في الأين بالحركة القطعية، أي: الحركة بين المبدأ والمنتهى وإن لم يتحقّق في الحركة التوسطية، وهي: كون الشيء في کلّ آن في حدّ أو مكان.
ثم لا يخفى عليك: عدم مجيء الاستصحاب في الزمان بحدّ أنّه الزمان؛ لعدم تعلّق الحكم الشرعي به. وإنّما يتعلّق به بتقطيعه بقطعات خاصّة في عالم الاعتبار كاليوم والساعة والشهر والسنة والقرن وغيرها. فالشهر مثلاً يكون محدوداً بحدوده يتحقّق القطع بوجوده والشكّ في بقائه، فيحكم ببقائه بالاستصحاب مطلقاً وإن كان الشكّ في المقتضي أو في خصوص الشكّ في الرافع.
هذا، ولا يخفى عليك: أنّه لا فرق في استصحاب الأمر التدريجي بين أن يكون استصحاب الشخص، أو الأمر الكلّي. ففي الشكّ في أنّ السورة الّتي شرع فيها تمّت أو بقيت منها شيء، يجوز فيه استصحاب الشخص واستصحاب الکلّي، وهو القسم الأوّل. وفي الشكّ في أنّ ما شرع فيها كان سورة الكوثر مثلاً أو سورة الإنسان يكون
ص: 172
من القسم الثاني من استصحاب الكلّي. وإذا شكّ في أنّه شرع في سورة اُخرى مع القطع بإتمامه السورة الّتي كانت بيده، فهو من القسم الثالث.
وأمّا ما اُخذ الزمان قیداً له كالصوم المقيّد به، فإن كان الشكّ في بقاء حكمه من جهة الشكّ في بقاء قيده مثل النهار الّذي قيّد به الصوم، يستصحب قيده ويحكم ببقاء النهار، أو يستصحب نفس المقيّد.((1))
وإن كان الشكّ من جهة اُخرى كما إذا شكّ في الحكم من جهة أن تقيّد موضوعه بقيد خاصّ تمام المطلوب، أو من باب تعدّد المطلوب؟ فيجري الاستصحاب فيه في خصوص ما اُخذ الزمان ظرفاً لثبوته لا قیداً له مقوّماً لموضوعه.
أمّا الأوّل، فلتحقّق أركان الاستصحاب بالنسبة إليه.
وأمّا الثاني، فلعدم تحقّقها، فإنّ ما علم بثبوته هو المقيّد بالزمان الخاصّ، وما شكّ في ثبوته هو غيره. وإن شئت قلت: ما علم بثبوته قد ارتفع، وما وقع الشكّ في ثبوته كان متيقّن العدم، فيستصحب عدمه.
فإن قلت: فيما إذا كان الزمان ظرفاً للموضوع لا مجال للقول بعدم دخل الزمان فيه رأساً وإلّا فلا وجه لأخذه ظرفاً له، فإذا كان للزمان فيه دخل مّا فلا مجال لاستصحابه، بل لابدّ من استصحاب عدمه.
قلت: بالنظر الدقّي العقلي كذلك، ولكنّ العرف المعتبر نظره يرى الموضوع واحداً في الزمانين، ولا يرى الزمان من مقوّمات الموضوع.
لا يقال: على هذا يتعارض الاستصحابان: استصحاب الثبوت واستصحاب
ص: 173
العدم، استصحاب الثبوت لوحدة الموضوع بنظر العرف، واستصحاب العدم لتعدّد الموضوع بنظر العقل.
فإنّه يقال: الاعتبار في وحدة الموضوع وتعدّده شرعاً بالنظر العرفي دون العقلي، فلا عبرة بالدقّة العقلية، فليس هنا إلّا استصحاب واحد وهو استصحاب الثبوت دون استصحاب العدم، لعدم الدليل على اعتباره.
وهذا بخلاف ما إذا اُخذ الزمان قيداً، فإنّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ غير الفعل في زمان آخر. اللّهمّ إلّا أن يكون بحسبه متّحداً عرفاً، كما إذا كان الشكّ في بقاء حكم المقيّد من جهة كونه بنحو التعدّد المطلوبي فإنّه لا يبعد فيه دعوى اتّحاد الموضوع وصحّة استصحاب الحكم.
لا يخفى عليك: أنّ ما ذكر من توهّم التعارض بين الاستصحابين محكيّ عن الفاضل النراقي(قدس سره).((1)) وحكي عنه أيضاً التعارض بينهما إذا كان الشكّ في البقاء من جهة عروض ما يشكّ في رافعيته، كما إذا شكّ في بقاء وجوب الصوم لعروض مرض يشكّ في بقاء وجوبه معه. وكما إذا حصل له الشكّ في بقاء الطهارة بعد المذي. وأيضاً كما إذا شكّ في طهارة الثوب النجس بعد الغسل بالماء مرّة. فاستصحاب عدم جعل الشارع وجوب الصوم مع المرض الّذي عرض له، وعدم جعل الوضوء سبباً للطهارة بعد المذي، واستصحاب نجاسة الثوب النجس بعد الغسل بالماء مرّة، يكون معارضاً لاستصحاب وجوب الصوم، ولاستصحاب الطهارة بعد المذي، ولاستصحاب عدم كون المنجّس الّذي تنجّس به الثوب بالملاقاة سبباً للنجاسة بعد الغسل مرّة، فعلى هذا، يتساقط الاستصحابان في مثل هذه الصور.
ص: 174
وأجاب صاحب الكفاية عن المثال الثاني والثالث: بأنّ الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها تكون ممّا إذا وجدت بأسبابها تبقى ولا تزول إلّا بما يكون رافعاً لها، فلا يشكّ في بقائها إلّا بالشكّ في تحقّق الرافع لها، فلا معنى لأصالة عدم جعل الوضوء سبباً للطهارة بعد المذي حتى يعارض بها أصالة بقاء الطهارة، ولا لأصالة عدم جعل الملاقاة سبباً للنجاسة بعد الغسل مرّة حتى يعارض بها أصالة بقاء النجاسة.((1))
ولم يتعرّض للمثال الأوّل فضلاً عن جوابه.
ولعلّ نظره إلى أنّ الشكّ في تلك الأمثلة کلّها يرجع إلى الشكّ في الرافع والأصل عدمه وبقاء ما شكّ في رفعه به.
نعم، في الجميع لا يكون الشكّ في وجود الرافع المعلوم رافعيته، بل تكون الشبهة حكمية في أنّ المذي هل يكون رافعاً للطهارة؟ أو الغسل مرّة هل يكون رافعاً للنجاسة؟ أو خصوص هذا المرض هل يكون رافعاً لوجوب الصوم أو مانعاً من تعلّق وجوبه؟ فتدبّر جيّداً.
ثم إنّ السيّد الاُستاذ أعلى الله مقامه قد أفاد في المقام في تعريف البقاء المعتبر في الاستصحاب:
إنّ البقاء يطلق تارة على ما هو المجرّد من الزمان كذات الله تعالى.
وتارة: يطلق على الزمان والزمانيات.
فبالاعتبار الأوّل يكون المراد منه الذات الّذي لا يزول ولا يزال فلا نهاية له ولا نفاد. والمراد من الثاني البقاء في آن متأخّر بعد كونه في الآن المتقدّم. وعلى ذلك للبقاء أربعة أقسام.
ص: 175
الأوّل: ما يطلق على الّذي هو باقٍ بنفسه خارج عن الزمان متقدّم عليه وعلى جميع الزمانيات بالذات وبالعلّية، وهو الباري تعالى.
الثاني: الموجود الممتدّ بالتدريج ذات أبعاض يتقدّم بعضها على بعض بالذات بحسب الوجود لا بالعلّية وينصرم المتقدّم قبل وجود المتأخّر، مثل الزمان نفسه.
الثالث: الموجود الامتدادي التدريجي في الزمان ومحدوداً بالحدّ الزماني، وله أيضاً أبعاض بعضها متقدّم على بعض بالذات وبالزمان وينصرم وجود بعضها قبل بعض، ويكون وجوده بتمامه عند انصرام تمامه ونفاد وجوده، مثل التكلّم والمشي والمركّبات الاعتبارية كالصلاة وغيرها من الاُمور التدريجية.
الرابع: ما هو موجود في الزمان بتمام أبعاضه وسائرٌ في الزمان بتمام وجوده، مثل وجود زيد وعمرو وحجر وشجر وغيرها.
وبعد ما عرفت من معنى البقاء وأقسام الموجودات الزمانية تعرف عدم جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات التدريجية، وذلك لعدم صدق البقاء عليها لا بالنسبة إلى أبعاضها، لأنّ کلّ بعض منها يتصوّر فهو يعدم وينتفي بعد وجوده، فليس له قرار حتى يحكم ببقائه، فلا يشكّ في شيء زال وانعدم حتى يحكم ببقائه بالاستصحاب. وأمّا بالنسبة إلى تمام وجوده فهو أيضاً ينعدم بمجرّد التمامية لا يفرض له وجود حتى يقع الشكّ في بقائه وزواله.
لا يقال: هذا تامّ بالنسبة إلى أصل الزمان. وأمّا بالنسبة إلى القطعة الخاصّة منه مثل ما سمّي بالنهار باعتبار محاذاة الشمس ومواجهتها للأرض في هذه القطعة من الزمان وبالليل باعتبار عدم محاذاتها لها، فلو شكّ في بقاء النهار أو بقاء الليل وهذه القطعة من الزمان نحكم ببقائه بحكم الاستصحاب.
فإنّه يقال: ننقل الكلام في هذه القطعة، فإنّه لا يعتبر البقاء في أبعاضها بعين ما قلناه
ص: 176
في أجزاء أصل الزمان. وبالنسبة إلى تمامها أيضاً لا يعتبر البقاء، لأنّه إن كان قبل التمامية لم يتحقّق وجودها حتى يشكّ في بقائها، وبعد تمامها لا وجود لها، فلا مجال لاعتبار البقاء لها.
فإن قلت: الحكم بالبقاء لا يصحّ باعتبار الحركة التوسّطية - الّتي عبّر عنها في الكفاية بالقطعية - ، وأمّا باعتبار الحركة القطعية - الّتي عبّر عنها في الكفاية بالتوسّطية - وهي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى يجوز اعتبار البقاء والشكّ فيه وهو متحقّق في الشكّ في مثل النهار والليل، فإنّه وإن لا يتحقّق جزء منه إلّا بعد انصرام جزئه السابق وليس في البين ما يحكم بالبقاء إلّا أنّ رفع اليد عن النهارية وعدم الحكم ببقائها عند العرف من نقض اليقين بالشكّ.
فبالنسبة إلى مثل النهار وإن لا يعتبر البقاء بالحركة التوسّطية لا مانع باعتباره بالنسبة إلى الحركة القطعية، فإنّ النهار والليل باعتبار كون الحركة الواقعة فيهما تكون بين المبدأ والمنتهى يفرض أمر قارّ يوجد بمجرّد وجوده في الآن الأوّل ويحكم ببقائه في الآن الثاني وما بعده.
قلت: هذا، أي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى،((1)) لا حقيقة له ولا منشأ لانتزاعه منه في الخارج، بل ليس إلّا مجرّد الفرض وليس في البين إلّا كون الشيء في کلّ آن في حدّ أو مكان ولا واقع لغير ذلك، فالحركة القطعية هي عين التوسّطية.
ثم إنّه يمكن تصحيح ذلك بأن يقال: إنّ النهارية تنتزع من صيرورة مواجهة الشمس مع الأرض وبهذا الاعتبار يصحّ الحكم بالبقاء، لأنّ الزمان الخاصّ المسمّى بالنهار يوجد بمجرّد تحقّق منشأ انتزاعه وهو سير الشمس ودخولها في قطعة خاصّة من الفضاء، فإذا شككنا في بقائها فيها نحكم به بالاستصحاب، فهي بهذا الاعتبار بمنزلة الاُمور القارّة التدريجية الّتي يقع الشكّ في استمرارها.
وإن أبيت عن ذلك فنقول: إنّ بعد الدقّة في الأخبار يحصل لنا أنّه لا يعتبر في جواز الاستصحاب صدق بقاء المستصحب، بل المعتبر ليس إلّا صدق نقض اليقين بالشكّ
ص: 177
وهو متحقق فی الشک فی مثل النهار واللیل، فانه وان لا یتحقق جزء منه الابعد انصرام جزئه السابف فی البین ما یحکم بالبقاء الا ان رفع الید عن النهاریه وعدم الحکم ببقائها عند العرف من نقض الیقین بالشک.
وبالجملة: يكفي في الاستصحاب صدق عنوان النقض ولو لم يكن في البين ما يصدق عليه البقاء، فالحكم يدور مدار صدق عنوان نقض اليقين بالشكّ لا البقاء فليس في الأخبار ما يدلّ على اعتبار صدق عنوان البقاء.((1))
ثم إنّه قد استشكل السيّد الاُستاذ في المقيّد بالزمان مثل الصوم: بأنّ استصحاب نفس النهار وإن كان يجري ولكن لا يثبت كون الإمساك في النهار.
وصاحب الكفاية اختار جريانه بتقريب: أنّ الإمساك قبل هذا الآن كان في النهار وفي الآن الحاضر نشكّ في كونه كذلك وواقعاً في النهار فيحكم ببقائه وكونه في النهار كما كان سابقاً فيه.
ولكن لا يستقيم ما أفاد لعدم اتّحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة، وذلك لأنّ الإمساك المطلوب في جميع النهار وإن كان إمساكاً واحداً إلّا أنّه بحسب آناء النهار يتبعّض بأبعاض كثيرة ليس الآن الّذي يشكّ في كونه من آناء النهار والإمساك فيه وجوداً بقائياً للآن السابق، فتدبّر((2)).
هل يجري الاستصحاب في الأحكام التعليقية المشروطة كما يجري في الأحكام الفعلية المطلقة؟
ص: 178
فقد أفاد في الكفاية:((1)) أنّه لا إشكال في جريانه في الأحكام التعليقية، لعدم اختلال ذلك في أركان الاستصحاب من اليقين بالثبوت والشكّ في البقاء.
ولا يرد على ذلك: أنّ المعلّق لا وجود له قبل وجود المعلّق عليه، وأنّه يختلّ بذلك أحد ركني الاستصحاب.((2))
فإنّه يردّ: بأنّ المعلّق لا يكون موجوداً قبل ما علّق عليه بالفعل ولكن كان موجوداً بنحو التعليق قبل الشكّ في بقائه، فيحكم ببقائه عند الشكّ فيه بالاستصحاب.
وبالجملة: فالحكم التعليقي كان ثابتاً بحكم مثل العنب إذا غلى يحرم، فإذا شككنا في بقائه لطروّ بعض الحالات نحكم ببقائه بحكم الاستصحاب.
ولا يعارض هذا الاستصحاب استصحاب الحلّيّة المطلقة للعنب؛ لأنّها كانت مغيّاة بعدم الغليان، فكما لا تعارض بين الحلّيّة المطلقة الثابتة بالقطع للعنب والحرمة التعليقية الثابتة له بالغليان ولا يجري استصحابها بعد ثبوت الغليان، لا يجري استصحاب الحلّيّة أيضاً مع جريان استصحاب الحرمة.
وإن شئت قلت: كما لا تعارض بين الحكم بحلّية العنب والحكم بحرمته إذا غلى، لا يقع التعارض أيضاً بين الاستصحابين استصحاب حلّيّة الزبيب واستصحاب حرمته إذا غلى.
وبعبارة اُخرى قلت: إنّما يقع التعارض بينهما لأنّ مقتضى استصحاب الحلّيّة المطلقة للعنب الثابتة له قبل الغليان وبعده حلّيّة الزبيب قبل الغليان وبعده، ومقتضى استصحاب الحرمة التعليقية الثابتة للعنب الحرمة التعليقية للزبيب، وهو مضادّ لاستصحاب الحلّيّة؛ لأنّ مقتضاه حلّية الزبيب بعد الغليان، ومقتضى الاستصحاب التعليقي حرمته بعد الغليان.
ص: 179
قلت: كما أنّه لا مضادّة بين أن يقال: العنب حلال، وأن يقال: العنب المغليّ حرام أو العنب إذا غلى حرام، لتقييد إطلاق الأوّل في الحلّيّة بعد الغليان بقوله: العنب المغليّ حرام، كذلك لا مضادّة بين استصحابهما.
استشكل في جريان الاستصحاب إذا كان المتيقّن من أحكام الشريعة السابقة وشكّ في بقائه وارتفاعه بنسخه، تارة: بعدم اليقين بثبوتها في حقّ من لم يدرك الشريعة السابقة، لاحتمال اختصاصها بالموجودين في زمانها فلا يقين بثبوتها في حقّ غير الموجودين حتّى يشكّ في بقائها.
وتارة اُخرى: بأنّا وإن فرضنا ثبوتها في حقّ غير المدركين لها حسب إطلاق أدلّتها، إلّا أنّه لا اعتبار لهذا الإطلاق بعد القطع بارتفاع مداليلها، لأنّ الشريعة السابقة صارت منسوخة بشريعتنا فلا شكّ في بقائها، للقطع بنسخها وعدم بقائها.
والجواب عن الأوّل: أنّ الحكم في الشريعة السابقة لم يثبت على الموجودين في الخارج بنحو القضايا الخارجية الّتي مصاديق موضوعاتها الأفراد الموجودة في الخارج، كما إذا قلنا: حضر علماء البلد المجلس الكذائي. بل إنّما ثبت للأفراد على نحو القضايا الحقيقية، كما في قوله تعالى: ﴿اَلْإِنْسانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾((1)) أو ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُ-سْرٍ﴾،((2)) فالحكم في هذه القضايا يشمل جميع أفراد موضوعاتها سواء كانت محقّقة الوجود أو مقدرّة. ولو لم يكن كذلك لما صحّ استصحاب الأحكام الثابتة في شرعنا الحنيف، ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجودين في زمان ثبوت الحكم فكما أنّ الحكم
ص: 180
في شريعتنا ثابت لعامّة الأفراد ممّن وجد أو يوجد ويستصحب إذا شكّ في بقائه، فالحكم في الشريعة السابقة أيضاً ثابت لمن وجد أو يوجد فيجري فيه الاستصحاب.
وأمّا الجواب عن القطع بنسخ الشريعة السابقة: أنّ ما ثبت من نسخ الشريعة السابقة عدم بقائها بتمامها لا ارتفاعها بجميعها.
لا يقال: إنّ العلم الإجمالي بارتفاع بعضها يمنع من استصحاب ما شكّ في بقائها.
فإنّه يقال: إنّه يمنع إذا كان المستصحب من أطراف ما علم ارتفاعه بالإجمال، وأمّا إذا علم بمقداره تفصيلاً بحيث كان الشكّ في مورد بدوياً، أو كان المشكوك فيه ممَّا علم عدم نسخه فلا يمنع عنه، بل يمكن أن نقول بالعلم التفصيلي بنسخ ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة دون غيرها.((1))
ثم إنّ الشيخ الأنصاري أجاب عن الإشكال الأوّل: بأنّ المستصحب هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكمُ قطعاً، غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة (المتغيّرة) في موضوع الحكم... إلخ.((2))
وربّما توهّم عبارته أنّ الحكم ثابت للكلّي كالملكية الثابتة في باب الزكاة والوقف العامّ، فلا مدخلية للأشخاص فيها، وإذا كان كذلك لا يصحّ تعلّق الزجر والبعث إليه.
وبعبارة اُخرى: الحكم بالكلّي يصحّ بالإضافة إلى المکلّف به لا المكلّف، فالملكية في باب الزكاة تكون في المکلّف به وهو کلّي. أمّا المكلّف فلا يعقل أن يكون کلّياً، لأنّه لا يعقل بعث الکلّي، فلابدّ أن يكون ذلك إمّا باعتبار أفراده الخارجية، أو أعمّ منها ومن أفرادها المقدّرة وجودها. ولعلّ الشيخ أراد ذلك.
ص: 181
وأجاب عن الثاني: بأنّا نفرض الشخص الواحد مدركاً للشريعتين فإذا حرم في حقّه شيء سابقاً وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلاً، فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاُولى.((1))
وأورد عليه المحقّق الخراساني: بأنّ الاستصحاب وإن كان يجري في حقّ المدرك للشريعتين، أمّا جريانه في حقّ من لم يدرك متوقّف على كونه كالمدرك على يقين بالحكم الثابت عليه في الشريعة والشكّ في بقائه، وليس لغير المدرك للشريعة السابقة اليقين بثبوت الحكم له والشكّ في بقائه.((2))
ويمكن أن يقال: نعم، لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى غير المدرك، أمّا جريانه في المدرك للشريعتين مستلزم للحكم به على غير المدرك وذلك للإجماع على عدم اختلاف تكليف المدرك وغير المدرك، فأفهم.
إعلم: أنّ مفاد الأخبار الّتي استدلّ بها على الاستصحاب - وهي عمدة أدلّته - إنشاء حكم مماثل للحكم المستصحب إذا كان المستصحب حكما من الأحكام. وإنشاء حكم مماثل لحكم الموضوع المستصحب إذا كان المستصحب موضوعاً من الموضوعات.
وليس مفادها تعميم الموضوع للحكم الواقعي، وذلك لتجرّد موضوعه من العلم والجهل والشكّ فيه، فلا يمكن أن يكون أعمّ من المجرّد عنها وممّا تعلّق الشكّ به أو كان مجهولاً أو معلوماً، لاختلاف رتبتهما وعدم إمكان لحاظهما معاً.
ولا يخفى عليك أيضاً: أنّ مفادها التعبّد بالمستصحب، بمعنى لزوم ترتيب آثاره
ص: 182
عليه إذا كان موضوعاً، والعمل على طبقه إذا كان المستصحب حكماً، فلا يجري في الموضوعات - الّتي لا يترتّب عليها حكم شرعي - لترتّب آثارها العقلية أو العادية، لكونها من الاُمور التكوينية الخارجة عن دائرة التشريع.
وإنّما الكلام في أنّه هل يجري في الموضوعات الّتي تكون لآثارها ولوازمها العقلية أو العادية آثار شرعية؟
وبعبارة اُخرى: هل يجري في الموضوع الّذي له أثر شرعي بواسطة أمر عادي أو عقلي يترتّب عليه؟ وهذا هو الّذي يعبّر عنه بالأصل المثبت، فيجري الكلام فيه بأنّه هل تشمله أخبار الباب؟ وهل ترفع اليد عن مثل ذلك من نقض اليقين بالشكّ؟
فمن يقول بالأصل المثبت يقول: إنّه من نقض اليقين بالشكّ، لاستلزام اليقين به اليقين بلازمه العقلي أو العادي، فهو وإن لم يكن ملتفتاً بهذا اللازم واللزوم بينه وبين الملزوم حين اليقين بالملزوم إلّا أنّه حين الشكّ في اللازم لا يشكّ في كونه موجوداً عند اليقين بالملزوم، فهو على يقين باللازم في السابق والشكّ في بقائه.
بل يمكن أن يقال: إنّ هذا استصحاب اللازم بنفسه وبلا واسطة، وليس الحكم به باستصحاب ملزومه. نعم، اليقين باللازم لازم اليقين بالملزوم.
ولكن يرد على ذلك: أنّ البحث في حجّية الأصل المثبت وعدمه إنّما يكون إذا كانت الملازمة بين المستصحب ولازمه في البقاء فقط دون الحدوث والبقاء، وفيما ذكر تكون الملازمة بين الحدوث والبقاء. والمثال للصورة الاُولى: ما إذا شككنا في الغسل في وجود الحاجب وعدمه فلازم استصحاب عدم وجود الحاجب وصول الماء إلى البشرة، فإنّ عدم وجود الحاجب قبل الغسل ليس ملازماً لوصول الماء إلى البشرة بل إذا كان باقياً إلى زمان الغسل يكون ملازماً له.
ومثل استصحاب حياة زيد الملازم لإنبات لحيته فإنّ نبات لحيته ليس لازم حدوثه بل هو لازم بقائه إلى هذا الزمان الخاصّ.
ص: 183
وبعد ذلك نقول: التحقيق عدم جريان الاستصحاب في هذه الاُمور والوسائط لإثبات ما يترتّب على الواسطة من الأحكام الشرعية؛ وذلك لأنّ الأخبار ظاهرة في التعبد بنفس المتيقّن لترتّب أثره الشرعي عليه، ولا تدلّ على التعبّد بترتيب الآثار المترتبة على ما هو الأثر العقلي والعادي للمستصحب.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الأمر العادي أو العقلي متّحداً مع المتيقّن في الوجود، كما في استصحاب عدم لبس غير المأكول الذي لازمه عدم كون ما عليه من اللباس الخاصّ غير المأكول، فإنّ عدم لبسه غير المأكول متّحد مع عدم كون لباسه من غير المأكول. أو كان خارجاً عن المتيقّن مقارناً لوجوده كإنبات اللحية لزيد مثلاً.
وبالجملة: لا يجري الاستصحاب لإثبات ما هو من اللوازم العقلية والعادية للمستصحب؛ لعدم تعلّق الجعل التشريعي بها. ولا يجري لترتّب الآثار الشرعية على تلك اللوازم لعدم دلالة الأخبار على التعبّد بنفس المتيقّن لترتّب آثاره الشرعية عليه.
هذا ولكن قد استثنى من ذلك الشيخ الأنصاري(قدس سره) ما إذا كانت الواسطة خفيّة، بحيث يرى العرف أثرها أثراً لذي الواسطة، فإنّ رفع اليد عن مثل ذلك يكون عندهم من نقض اليقين بالشكّ.((1))
وقال المحقّق الخراساني في حاشيته على الفرائد: وذلك لما عرفت من أنّ الدلالة على الأثر الّذي بلحاظه يكون التنزيل في مورد الاستصحاب إنّما هو بمقدّمات الحكمة، ولا يتفاوت بحسبها فيما يعد عرفاً أثراً بين ما كان أثراً بلا واسطة أو معها، كما لا يخفى. ولا يذهب عليك: أنّ ذلك من باب تعيين مفهوم الخطاب بمتفاهم العرف لا من تطبيق المفاهيم على مصاديقها العرفية خطأً أو مسامحة، كما توهّمه بعض السادة من الأجلّة(قدس سره) فأشكل عليه بأنّه لا اعتبار بمسامحات العرف في التطبيقات.
ص: 184
فكأنّه(قدس سره) توهّم من مطاوي کلماته(قدس سره) (أي کلما ت الشيخ) أنّه استظهر من الخطاب وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة بالاستصحاب، ومع ذلك ألحق به ما بالواسطة الخفيّة لتطبيقه عليه بالمسامحة العرفية وإن لم يكن منطبقاً عليه حقيقة.
وغفل عن أنّه بصدد ادّعاء أنّ الظاهر منه هو وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة عرفاً، فيكون تطبيقه على ما يكون بلا واسطة كذلك (أي عرفاً) تطبيقاً حقيقياً دقيقاً بلا مسامحة.
وسرّه: أنّه قد مرّ أنّ تعيينه بمقدّمات الحكمة وليس ما لا واسطة له أصلاً بالإضافة إلى ما لا واسطة له عرفاً بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب، كما لا يخفى. ولا اعتبار بالقطع بإرادة مقدار من الخارج، فإنّ المدار فيها إنّما هو على القطع به في مقام التخاطب كما حقّقناه في البحث غير مرّة، فتأمّل تعرف سرّه.((1)) انتهى.
ثم إنّه قد أضاف المحقّق الخراساني(قدس سره) إلى ما استثنى شيخه(قدس سره): الأثر المترتّب على المستصحب بوساطة ما لا تفكيك بينهما عرفاً، كما إذا كان لزوم اللازم للمستصحب بمثابة من الوضوح وبحيث يعدّ أثره أثراً للملزوم ويعدّ عند العرف رفع اليد من ذلك الأثر نقضاً لليقين بوجود المستصحب. أو عقلاً كما إذا كان اللازم ممّا لا يمكن التفكيك بينه وبين ملزومه.((2))
ولكنّ الظاهر أنّ ذلك وإن صحّ من حيث الكبرى ولكنّه خارج عمّا فيه البحث، لأنّ البحث في الأصل المثبت إنّما يكون فيما إذا كانت الملازمة بين المستصحب ولازمه في البقاء فقط، وأمّا إذا كانت الملازمة بينهما في الحدوث والبقاء فكلّ منهما بالاستقلال مجرى الاستصحاب.
ص: 185
وبالجملة: الظاهر عدم وجود مورد تكون الملازمة بين المستصحب ولازمه في البقاء بهذه المثابة، فليس ما ذكره إلّا مجرّد الفرض.((1))
الفرق بين مثبتات الأمارة والأصل
بقي في المقام بيان وجه الفرق بين الأمارة والأصل، حيث إنّ مثبتات الأمارة حجّة دون الأصل.
وأفاد المحقّق الخراساني: بأنّ الأمارة كما تحكي عن المؤدّى ويشير إليه، كذا تحكي عن أطرافه من الملزوم واللازم. ومقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها ومقتضى ذلك حجّية المثبت منها. بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنّه لا يدلّ على أزيد من التعبّد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره، ولا يدلّ على التعبّد بثبوت ما هو الأثر لما يترتّب على المستصحب من اللازم العادي أو العقلي.((2))
ويمكن أن يقال: إنّ الأمارة مؤدّاها أعمّ من نفسه ولازمه وملزومه. وفيها جهة كشف عن الواقع اعتبرت بحكم الشارع، وليس ذلك في الاستصحاب وإن كانت في الحالة السابقة أيضاً كشف عن الواقع، فهو عند العرف مختصّ بالمستصحب بملاحظة أثره، والشارع أيضاً تعبّدنا به دون غيره. والسيرة وعمل العرف أيضاً في الأمارة على ذلك، ودليل حجّيتها إمضاء للسيرة، وليس هذا في الاستصحاب كما لا يخفى.
وقد كان ذكره في ذيل التنبيه السابع أولى، لكونه ممّا يتفرّع عليه لدفع بعض التوهّمات:
ص: 186
إنّ استصحاب الفرد أو منشأ الانتزاع لترتيب آثار الكلّي الطبيعي، أو العرض على الفرد أو على منشأ الانتزاع مثبت.((1))
ومنشأ هذا التوهّم يمكن أن يكون أحد أمرين: أحدهما: مغايرة الكلّي مع أفراده وجوداً، فإذا شككنا في خمرية مائع كان متيقّن الخمرية سابقاً وأردنا استصحاب خمريته لأن نثبت به حرمته، نقول: إنّ الأصل - أي مقتضى الاستصحاب - بقاء المائع على حالته السابقة، ولازم ذلك بقاء طبيعة الخمرية الّتي كانت معه للملازمة بين بقائه وبقائها، ولكن هذا اللزوم ليس شرعياً حتى يحكم بحرمة المائع المذكور، فيكون إثبات حرمته بهذا الاستصحاب مثبتاً.
والجواب عن ذلك: أنّ وجود الطبيعة في الخارج ليس مغايراً لوجود الفرد بل هو موجود بعين وجود الفرد، فما كان متيقّناً هو الكلّي الموجود بوجود الفرد وهو عين وجوده وما يستصحب أيضاً هو ذلك الكلّي.
هذا مضافاً إلى أن الحكم الكلّي المتعلّق بالطبيعة ينحلّ إلى أحكام جزئية حسب أفرادها فيستصحب في المثال الخمر الجزئي الموجود بهذا الفرد فيترتّب عليه الحكم بحرمته.
ثانيهما: أن يقال: إنّ أثر الكلّي - وهو الحرمة في المثال - يترتّب على الفرد بجميع مشخّصاته الخارجية، فالمائع المتيقّن حرمته لخمريته حرام بجميع مشخّصاته الخارجية فإثبات بقاء حرمته بجميع تلك المشخّصات باستصحاب بقاء خمريته المستلزم عادة لبقاء هذه المشخّصات يكون مثبتاً.
وأجاب السيّد الاُستاذ - كما حكى عنه المقرّر في الحاشية - بأنّ الآثار المترتّبة على
ص: 187
الفرد بتوسّط الكلّي إنّما تكون مترتّبة عليه بما هو فرد للكلّي لا بما هو مقارن مع مشخّصاته الخارجية، فإنّه ليس في الأحكام الشرعية ما هو مترتّب على الفرد الخارجي بجميع مشخّصاته، بل إنّما تكون مترتّبة على الكلّي المنطبق على أفراده خارجاً والمتّحد معها وجوداً. انتهى.((1))
ولا يخفى عليك: أنّ وجود العرضي كالملكيّة ممّا ينتزع من منشأ انتزاعه أيضاً يكون كالكلّي، والفرد وجوده بعين وجود منشأ انتزاعه لا وجود له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه، فاستصحاب منشأ انتزاعها يكفي لترتيب أثرها بدون توسيط ثبوته لأنّه لا ثبوت لها زائداً على ثبوت منشأ انتزاعها.
إنّ الاستصحاب كيف يجري في الأحكام الوضعية المنتزعة من التكاليف، كالجزئية والشرطية والمانعية؟! فإنّ هذه الاُمور ليست من المجعولات الشرعية فلا تثبت إلّا بالأصل المثبت.((2))
والجواب: أنّها وإن لم تكن مجعولة بنفسها إلّا أنّها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها، ويكفي ذلك في شمول الأخبار لها، فإنّ المقصود من الآثار الشرعية ما تناله يد الجعل وضعاً ورفعاً ولو كان بجعل منشأ انتزاعه.
إنّ الاستصحاب لا يجري في عدم التكليف، لأنّه ليس أمراً قابلاً للجعل، مع أنّ
ص: 188
اللازم في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه أمراً مجعولاً أو ذا أثر مجعول، والعدم ليس من الأحكام وإلّا يلزم أن تكون الأحكام الخمسة، عشرة.
والجواب عنه: أنّ مقتضى الاستصحاب التعبّد بالمستصحب والبناء العملي عليه سواء كان أمراً وجودياً أو عدمياً، لا إنشاء حكم مماثل للمستصحب حتى يكون مجراه اليقين بالحكم السابق أو موضوع ذي حكم، وعدم التكليف إنّما يكون ممّا يبني عليه المکلّف بحكم الاستصحاب ويستريح به عن مشقّة التكليف.
وبالجملة: الاستصحاب كما يجري في کلّ مورد يكون وجوده متعلّقاً للتكليف يجري في عدمه. والقول بالتفصيل فهو من الأقوال في المسألة وقد اُجيب عنه في محلّه.
وقد فرّع على ذلك في الكفاية صحّة الاستدلال على البراءة باستصحاب عدم المنع والبراءة من التكليف.((1))
خلافاً للشيخ حيث اختار عدم جريان الاستصحاب فيها؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب ليس من اللوازم المجعولة الشرعية، لعدم المنع حتى يثبت باستصحاب عدم المنع.((2))
وفيه: أنّ عدم استحقاق العقاب ليس لازم أخصّ لعدم المنع الواقعي حتى يكون استصحابه لترتّب عدم استحقاق العقاب عليه مثبتاً، بل هو لازم عدم المنع أعمّ من الواقعي والظاهري، فإذا استصحبنا عدم المنع يترتّب عليه أثره وهو عدم استحقاق العقاب كما يترتّب على عدم المنع الواقعي.
ص: 189
وبعد ذلك کلّه استشكل السيّد الاُستاذ على الاستدلال بالاستصحاب على البراءة: بأنّ النسبة بين الاستصحاب والبراءة التباين، فلا يمكن إثبات أحدهما بالآخر.
ييان ذلك: إنّ ما هو تمام الموضوع في البراءة احتمال التكليف فقط من دون مدخلية شيء آخر فيه، كاليقين السابق، وما هو تمام الموضوع في الاستصحاب الشكّ اللاحق واليقين السابق، فكيف يستدلّ بدليل أحدهما على إثبات الآخر.((1))
أقول: لم يتحصّل لي مراده(قدس سره)، ولعلّ المقرّر لم يأت بتمام مرامه، فإنّه لا شكّ في عدم صحّة الاستدلال بدليل الاستصحاب على البراءة لما بين موضوعيهما من التباين. ولكن لماذا لا يصح الاستدلال بالاستصحاب على البراءة باستصحاب عدم المنع والبراءة الأصلية الثابتة قبل الشرع إذا شككنا في وجوب فعل أو حرمته.
ومن ذلك يظهر ما في ذيل کلامه من الاستشكال زائداً على ما أفاد بأخصّية الاستصحاب من البراءة.((2))
هذا، وقد أفاد - رضوان الله عليه - في وجه جريان الاستصحاب في الجزئية والشرطية والمانعية بأنّ التعبّد بجزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته ليس إلّا التعبّد ببقاء الوجوب الضمني الّذي كان متعلّقاً بهذا الجزء، كما أنّ التعبّد بعدم الجزئية عبارة عن عدم فعلية وجوب ما شكّ في وجوبه. فعلى هذا، يكون التعبّد بالجزئية والشرطية والمانعية ممّا تناله يد الجعل التشريعي وضعاً ورفعاً فلا يكون مثبتاً أصلاً، وكما قال: لا مجال لتوهّمه أبداً.((3))
ص: 190
من الاُمور الّتي ينبغي ذكرها ذيل التنبيه السابع: أنّ ما ذكر في التنبيه المذكور - من عدم حجّية جعل المثبت، أي عدم ترتّب الأثر العادي أو العقلي على المستصحب، ولا الأثر الشرعي المترتّب عليه بواسطة الأثر العادي أو العقلي المترتّب عليه - إنّما يكون بالنسبة إلى ما كان أثراً للمستصحب بوجوده الواقعي دون ما إذا كان الأثر لأعمّ من وجوده الواقعي والظاهري. فوجوب إطاعة الحكم المستصحب - سواء كان واجباً أو حراماً - أثر عقلي لاستصحاب الحكم بوجوده الأعمّ من الواقعي والظاهري ويترتّب على استصحابه. وذلك لاستقلال العقل بوجوب إطاعة أمر المولى سواء كان ظاهرياً أو واقعياً ثبت بالقطع أو بالظنّ المعتبر أو بالأصل. فباستصحاب الوجوب وإجراء الأصل يتحقّق ما هو موضوع لحكم العقل، أي أمر لمولى وإيجابه. ومثل هذا خارج عن الاُصول المثبتة، فتدبّر.
إعلم: أنّ ما هو المعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب - على فرض بقائه في حال استصحابه حكماً أو موضوعاً - ذا حكم وإن لم يكن كذلك فى حال ثبوته واليقين به فيجري إذا كان المستصحب في حال الشكّ في بقائه حكماً أو موضوعاً ذا حكم وإن لم يكن في حال كونه معلوم الثبوت كذلك. كما أنّه لا يجري إذا كان في حال كونه متيقّن الثبوت حكماً أو موضوعاً ذا حكم دون حال الشكّ في بقائه. وذلك لصدق نقض اليقين بالشكّ في الصورة الاُولى لو رفع اليد عنه وترك العمل به، بخلاف الصورة الثانية، كما هو واضح.
وبالجملة: يصحّ التعبّد بالبقاء في الصورة الاُولى وتشملها الأخبار، دون الصورة
ص: 191
الثانية. وعليه لا يضرّ كون المستصحب مثل عدم التكليف في الأزل وأنّه غير قابل للجعل بعد ما يكون قابلاً له في زمان الشكّ ، فتدبّر.
لا إشكال في جريان الاستصحاب إذا كان الشكّ في أصل تحقّق حكم أو موضوع، كنجاسة هذا الشيء، أو موت زيد.
وأمّا إذا كان الشكّ في تقدّمه وتأخّره، كما إذا علم بانتقاض اليقين - بوجود شيء أو عدمه - في زمان مثل يوم الجمعة وشكّ في أنّ انتقاضه حدث قبل ذلك الزمان مثل يوم الخميس بعد اليقين بعدم انتقاضه قبله، فهل تترتّب عليه آثاره في يوم الشكّ في انتقاضه أي يوم الخميس أو لا؟
وهذا الّذي يعبّر عنه بأصالة تأخّر الحادث، أي مقتضى الأصل تأخّر حدوث ما انتقض به اليقين.
إذا عرفت ذلك: فنقول: إنّ التأخّر والتقدّم إن لوحظا بالنسبة إلى أجزاء الزمان، كما إذا علم بوجود أمر مثل موت زيد يوم الجمعة وشكّ في وقوع موته يوم الخميس، ففي مثله يجري الاستصحاب لإثبات الآثار المترتّبة على عدم موته في زمان الشكّ في موته، فيقال: إنّ الأصل بقاء حياته أو عدم موته إلى يوم الخميس، وذلك لتحقّق أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشكّ اللاحق.
ولا دافع لذلك إلّا توهّم اعتبار كون زمان احتمال الانتقاض حالاً لا ماضياً ولا مستقبلاً، فيقال: إنّ الاستصحاب يجري في مثل الشكّ في مثل بقاء زيد المتيقّن وجوده في السابق، فإنّ هنا زمان احتمال الانتقاض حال، بخلاف المثال المذكور إذ زمان وقوع الانتقاض المحتمل ماضٍ.
ص: 192
ويدفع هذا التوهّم بإطلاق أخبار الباب وصدق نقض اليقين بالشكّ - بالبناء على خلاف الحالة السابقة - في المثالين على السواء.
نعم، لا تترتّب آثار عنوان حدوث موته يوم الجمعة باستصحاب عدم موته إلى يوم الخميس إلّا على القول بالأصل المثبت، لأنّ اللازم العقلي لعدم موته إلى يوم الخميس هو حدوث موته يوم الجمعة.
اللّهمّ إلّا أن يقال: بخفاء الواسطة، أو عدم التفكيك بين تنزيل عدم تحقّق موته إلى يوم الخميس وحدوثه يوم الجمعة.
أو يقال: بأنّ حدوث موت زيد يوم الجمعة مركّب من عدم موته إلى يوم الخميس وحياته في يوم الجمعة، فالأوّل محرز بالأصل والثاني بالوجدان.
وهكذا يجري الكلام في عدم ترتيب آثار عنوان تأخّر موته عن يوم الخميس.
هذا إذا لوحظ التقدّم والتأخّر بالنسبة إلى نفس الزمان.
وأمّا إذا لوحظ تقدّم حدوث شيء أو تأخّره بالنسبة إلى حادث آخر هو أيضاً معلوم الحدوث وشكّ في تقدّمه عليه أو تأخّره عنه، وذلك كما إذا علم بموت متوارثين وشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر. فإذا كان الأثر للوجود الخاصّ لأحدهما من التقدّم والتأخّر والتقارن، لا للآخر ولا له بنحو آخر كتحقّقه في زمان الآخر، أو على نحو خاصّ على نحو مفاد كان التامّة، فشككنا مثلاً في موت زيد المتقدّم على موت عمرو، ففي مثله يجري استصحاب عدم موته الخاصّ في الزمان المتقدّم على زمان موت عمرو فإنّه كان قبل موت عمرو مسبوقاً بالعدم.
وأمّا إذا كان الأثر مترتّباً على وجوده إذا كان متّصفاً بوصف خاصّ من التأخّر أو التقدّم على نحو كان الناقصة، فاستصحاب عدم وجوده وإن كان يجري لكونه مسبوقاً بالعدم ولكن لا يجري استصحاب عدم كونه متّصفاً بالوصف الخاصّ لعدم حالة
ص: 193
سابقة له من وجوده مع هذا الوصف أو بدونه، لأنّه لم يثبت له وجود في زمان حتى يشكّ في اتّصافه فى ذلك الزمان بهذا الوصف فيستصحب عدمه، بل هو حدث إمّا متقدّماً أو متأخّراً.
وبعبارة اُخرى: إذا كان موضوع الأثر أمراً واحداً كوجود خاصّ مثل الموت في الزمان المتقدّم على زمان الآخر يجري استصحاب عدمه لوجود الحالة السابقة فيه. وإذا كان أمرين: أحدهما أصل وجود الموضوع، وثانيهما كونه متّصفاً بوصف خاصّ فلا يجري فيه، لأنّه لم تكن لكونه موصوفاً بهذا الوصف حالة سابقة حتى يستصحب.
ولا يخفى: أنّ ما ذكر يكون بقطع النظر عن المعارضة، فإذا كان للحادث الآخر أيضاً أثر متقدّم على الآخر أو متأخّر عنه لا يجري الاستصحاب؛ لمكان المعارضة بينه وبين الاستصحاب الجاري في الطرف الآخر.
وأمّا إذا كان الأثر لعدم الحادث متقدّماً أو متأخّراً على الآخر فلا يخلو إمّا أن يكون الأثر للعدم بوصف كونه في زمان الآخر بأن يكون هنا أمران أحدهما عدم الحادث، والثاني اتّصاف هذا العدم بكونه في زمان الآخر على نحو مفاد ليس الناقصة.
وإمّا أن يكون للعدم الخاصّ أي العدم في زمان الآخر، لا موصوفاً بكونه في زمان الآخر على نحو مفاد ليس التامّة.
فعلى الأوّل، لا يجري الاستصحاب أيضاً لا للمعارضة بل لعدم الحالة السابقة كما قلنا به في الوجودي. إلّا أنّ الظاهر وجود الفرق بين ما ذكر في الوجودي والعدمي، فإنّ في الوجودي إنّما لا يجرى الأصل لعدم الحالة السابقة، لأنّه لم يكن له زمان كان متّصفاً فيه بالوصف الكذائي أو غير متّصف به، فهو إذا وجد وجد متّصفاً به أو غير متّصف به، فليس له قبل الحدوث بحسب هذا الوصف وجوداً أو عدماً حالة سابقة. وذلك بخلاف العدمي، فإنّ مثل عدم موت الأب زمان موت ابنه له حالة سابقة وهي
ص: 194
عدم موت الأب قبل موت ابنه، فيجري استصحاب حالته السابقة إلى زمان موت الإبن. إلّا أن يعتبر فيه ما يختلّ به الحالة السابقة، كأن يقال باعتبار الأثر لعدم موت الأب متّصفاً بكونه في زمان حدوث موت الابن، ومن المعلوم أنّه ليست لذلك حالة سابقة، فلا يجري فيه الاستصحاب. وهذا مراد المحقّق الخراساني(قدس سره) بقوله: «بأن يكون الأثر للحادث المتّصف بالعدم في زمان حدوث الآخر»،((1)) فتدبّر.
وعلى الثاني، أي على أن يكون الأثر للعدم الخاصّ، أي العدم في زمان الآخر على نحو مفاد ليس التامّة، إنّما لا يجري الأصل من جهة عدم إحراز موضوعه وهو ما إذا كان زمان الشكّ متّصلاً بزمان اليقين، كما إذا كنّا على يقين بالطهارة وشككنا في بقائها.
وأمّا إذا شككنا في الطهارة بعد اليقين بالحدث فلا ريب في عدم صحّة إجراء الأصل في الطهارة، لفصل زمان اليقين بالحدث بين اليقين بها والشكّ فيها. وكذا إذا كان وقوع الفصل بين زمان اليقين والشكّ مشكوكاً فيه لم يحرز اتّصال زمانهما فإنّه يكون من الشبهة المصداقية لعموم قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا تنقض اليقين بالشكّ».
ونوضح ذلك في مثال، فنفرض في موت الوالد الكافر وإسلام ولده: أنّهما متيقّن العدم يوم الخميس، وحدوث أحدهما لا على التعيين يوم الجمعة والآخر يوم السبت، فشككنا في أنّ إسلام الولد هل وقع قبل موت الوالد حتى يرث الولد منه تمام تركته أم وقع بعده؟ فلا يجري استصحاب عدم إسلامه إلى زمان موت الوالد. وذلك لأنّ زمان الشكّ في إسلامه زمان موت والده، فاتّصال زمان الشكّ في إسلامه، أي زمان موت والده، بزمان اليقين بعدم إسلامه مشكوك؛ لاحتمال وقوع إسلامه يوم الجمعة وفصل زمان اليقين بإسلامه بين زمان اليقين بعدمه وزمان الشكّ في إسلامه، فيكون التمسّك بقوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا تنقض اليقين بالشكّ» لإثبات عدم إسلام الولد إلى زمان موت والده
ص: 195
من التمسّك بعموم العامّ في الشبهة المصداقية، لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ في عدم إسلام الولد بزمان اليقين به.
وأيضاً قد مثّل لذلك السيّد الاُستاذ(قدس سره) - كما حكى المقرّر - بهذا المثال وإليك عين عبارة المقرّر عنه: «أنّا نفرض في موت الوارثين - اللذين ماتا متعاقبين - ثلاث ساعات مثلاً: الساعة الاُولى زمان اليقين بعدم حدوث موتهما، الساعة الثانية زمان حدوث الموت لأحدهما، والثالثة زمان حدوث موت الآخر. ونفرض أيضاً زمان الشكّ هو الساعة الّتي مات فيها الآخر مثلاً، وتلك الساعة الّتي تكون زمان الشكّ على المفروض مردّدة بين الثانية والثالثة. فإن كانت هي الثانية يكون زمان الشكّ متّصلاً بزمان اليقين وهو الساعة الاُولى، وعلى هذا الفرض لا مانع عن استصحاب عدم حدوث الموت لزيد مثلاً لاتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين. وإن كانت هي الثالثة يكون زمان الشكّ منفصلاً عن زمان اليقين، وعلى هذا الفرض لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب لعدم حدوث الموت لزيد إلى الساعة الثالثة الّتي تكون في هذا الفرض زمان الشكّ، لأنّ الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء المستصحب في زمان الشكّ، وفي المفروض لا يكون الحكم بالبقاء، بل إنّما يكون الحكم بالحدوث، لأنّ المستصحب - وهو عدم موت زيد في المثال - قد انتقض وارتفع في الساعة الثانية وبعد ارتفاعه لا معنى للحكم ببقائه إلى الثالثة، وذلك هو السرّ في اشتراط اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين».((1))
ولا يخفى عليك: أنّ في مثل المثالين المذكورين يكون الموضوع - للخطابات والأخبار الواردة في الاستصحاب وحرمة نقض اليقين بالشكّ ووجوب إبقاء ما كان على ما كان - مشكوكاً فيه.
ثم إنّ هنا مثالاً آخر، فيه، إشكال عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين، وهو في
ص: 196
الحادثين المتضادّين كالطهارة والحدث أو الخبث، بأن نفرض ثلاث ساعات: الساعة الاُولى والثانية تكونان زمان اليقين بثبوتهما مع الشكّ في المتقدّم والمتأخّر، والساعة الثالثة زمان الشكّ في بقائهما، فإنّ فيه لا يجري استصحاب بقاء الطهارة، لأنّ زمان الشكّ في بقائها غير معلوم الاتّصال بزمان اليقين بها لإمكان تقدّم الطهارة على الحدث أو الخبث. نعم، على فرض تأخّرها عنه يكون الاتّصال المعتبر حاصلاً إلّا أنّه مشكوك فيه. وهكذا لا يجري استصحاب الحدث لنحو ما ذكر.((1))
وقد ردّه المقرّر الفاضل ذيل الصفحة وهو بتقريب منّا: أنّ في مثال المتوارثين زمان الشكّ في کلّ منهما زمان حدوث الآخر، ولذا لا يمكن إحراز اتّصال زمان الشكّ فيه بزمان اليقين بعدمه لإمكان حدوثه في الساعة الثانية أو في يوم الجمعة ووقوع نقض اليقين بعدمه باليقين بحدوثه.
وفي مثال المتضادّين لا معنى للشكّ في بقاء أحدهما في زمان حدوث الآخر لاستحالة اجتماع الضدّين، فلا معنى لاعتبار الشكّ فيهما بالإضافة إلى زمان حدوث الآخر للتضادّ بينهما، فاعتبار الشكّ في کلّ منهما يكون باعتبار الشكّ فيهما بالإضافة إلى أجزاء الزمان فيكون زمان الشكّ متّصلاً بزمان اليقين، وإنّما لا يجري الاستصحاب لوقوع المعارضة بين الأصلين.((2))
ثم إنّ هذا کلّه في مجهولي التاريخ وأمّا إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهولاً فيجري فيه أيضاً ما ذكر في مجهولي التاريخ، فيجري استصحاب عدم وجود ما شكّ في وجوده بنحو
ص: 197
آخر على نحو مفاد كان التامّة، لأنّ استصحابه كذلك يكون بلا معارض إذا كان الأثر مترتّباً على وجوده كذلك. بخلاف ما إذا كان الأثر مترتّباً على وجود کلّ منهما أو لكلّ أنحاء وجوده، فإنّه لا يتّجه استصحاب العدم في کلّ من الطرفين أو الأطراف لوقوع المعارضة بين الاستصحابين. ولا يجري إذا كان على نحو مفاد كان الناقصة لعدم الحالة السابقة على التفصيل الّذي مرّ.
وأمّا إذا كان الأثر مترتّباً على عدم الحادث في زمان الآخر على نحو مفاد ليس التامّة، فيجري استصحاب عدمه في مجهول التاريخ منهما لاتّصال زمان شكّه بزمان يقينه، دون معلوم التاريخ. بخلاف ما إذا كان على مفاد ليس الناقصة، فإنّه لا يجري فيه الاستصحاب لعدم اليقين بالاتّصاف سابقاً، والله هو العالم.
قد عرفت ممّا سبق:((1)) أنّ الاستصحاب مورده الحكم الشرعي أو الموضوع للحكم الشرعي، فإذا كان المستصحب حكماً شرعياً كوجوب إكرام زيد، أو موضوعاً لحكم شرعي كخمرية مائع، وشكّ في بقاء وجوب الإكرام أو خمرية المائع، يجري استصحاب الوجوب في الأوّل والخمرية في الثاني.
وأمّا الموضوع اللغوي، فقد مثّل له بمثل الصعيد المتيقّن كونه حقيقة في مطلق وجه الأرض، وشكّ في بقائه على المعنى الحقيقي عند نزول قوله تعالى: ﴿فَ-تَ-يَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾،((2)) فيترتب على استصحاب معناه الحقيقي الحكم بجواز التيمّم على مطلق وجه الأرض.
ص: 198
ولكن التمسّك لإرادة هذا المعنى منه يكون مثبتاً، لأنّ إرادته من اللفظ تكون من الآثار العرفية للمستصحب.
اللّهمّ إلّا أن يقال: بجريان الأصل المثبت في باب اللغات، أو يبنى على خفاء الواسطة.
ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون المورد من الاُمور الاختيارية العملية الّتي تتعلّق بالعمل الجوارحي، أو العمل الجوانحي والقلبي. وأمّا الّتي كان المهمّ فيها شرعاً المعرفة واليقين، فلا يجري فيها الاستصحاب لعدم ترتّب هذا الأثر عليه وعدم إمكان التعبّد بها، لأنّها من الاُمور الحقيقية الخارجية الّتي لا تتحصّل بالتعبّد بها والبناء عليها والجري العملي عليها.
إذن، فإذا كانت الموافقة الالتزامية في الأحكام الفرعية واجبة يمكن أن يقال - إذا استصحبنا وجوب إكرام زيد أو خمرية مائع - : كما تجب موافقته بالعمل الجوارحي تجب موافقته قلباً وبالعمل القلبي بالبناء عليه والتسليم له.
أمّا في الاُمور الاعتقادية مثل وجود الله تعالى وأسمائه وصفاته الكمالية ممّا يكون المطلوب فيها العلم والمعرفة واليقين، فإذا شكّ فيه - والعياذ به تعالى - لا يجري الاستصحاب، لأنّ الشكّ فيه يسري إلى اليقين السابق ويزيله هذا أوّلاً. وثانياً: لأنّه لا يترتّب الأثر المطلوب منه - أي العلم واليقين - على استصحابه.
ويمكن بيان عدم جريان الاستصحاب بوجه آخر، وهو: أنّه مع حفظ اليقين بالله تعالى يستحيل الشكّ فيه والجمع بين اليقين به والشكّ فيه، بخلاف موارد الاستصحاب المفروض فيها اليقين الفعلي بوجود المستصحب في الزمان السابق والشكّ الفعلي في وجوده، فمثل وجود الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية والمعاد ومثل الحساب والميزان ووجود الملائكة ونبوّة الأنبياء كنبوّة إبراهيم وموسى وعيسى(علیهم السلام) ونبيّنا خاتم الأنبياء(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وكذا الولاية الحكومية الثابتة للنبيّ والأئمّة(علیهم السلام)
ص: 199
من الاُمور المتقوّمة بحياتهم العنصرية دون شؤونهم الذاتية الّتي لا تزول بارتحالهم، فلا يتطرّق الشكّ في بقاء تلك الحكومة، لأنّها ثابتة لهم ما داموا هم في هذه الدنيا، فلا يمكن اجتماع بقاء اليقين بها في زمان والشكّ فيها في زمان آخر.
نعم، يمكن الشكّ في بقاء هذه الشؤون الدنيوية لهم للشكّ في بقاء حياتهم ولكن استصحاب حياتهم أيضاً لا يوجب القطع واليقين بها فيجب الفحص عنها لوجوب معرفة إمام الزمان، ومثل هذا الشكّ لا يقع في إمام زماننا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) الّذي لو بقيت الأرض بغير وجوده لساخت بأهلها، وبالنسبة إلى الأنبياء(علیهم السلام)، فلا معنى للشكّ في حياتهم لارتحالهم صلوات الله عليهم إلى الله تعالى، وبالنسبة إلى نبوّتهم أي بقاء شريعتهم ممّا هو مختصّ بشرائعهم فلا شكّ في نسخ الجميع بالشريعة الخاتمية المحمدية، وبالنسبة إلى بعض الأحكام ممّا يحتمل بقاؤه في هذه الشريعة، فيجري فيه الاستصحاب. وأمّا بالنسبة إلى شريعة نبينا(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) الشريعة الخاتمية، فالشكّ فيها إن وقع يرجع إلى نسخ بعض الأحكام في عصر الرسالة، وأمّا الشكّ في أصل الشريعة ونسخ تمام الأحكام أو بعضها بعد عصر الرسالة فهو خلاف ما قامت به الضرورة بين المسلمين فحلال محمّد(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
ثمّ إنّه هل يجوز للكتابي إن شكّ في بقاء شريعة موسى - مثلاً - التمسّك بالاستصحاب لإثبات بقاء شريعته، فيجوز له ترك النظر في دعوى مدّعي النبوّة ونسخ أحكام الشريعة السابقة؟
يمكن أن يقال: إنّه لا يترتّب على استصحاب بقاء شريعة موسى جواز ترك النظر في دعوى مدّعي النبوّة والفحص عن صدقه، غاية الأمر يثبت به وجوب الجري العملي
ص: 200
على طبق المستصحب والبناء عليه ظاهراً إذا لم يكن شكّه في البقاء من جهة الشكّ في صدق مدّعي النبوّة، فإنّه لا يجوز له حينئذٍ البناء على الاستصحاب وترك الفحص.
يمكن أن نقول: إنّ الشكّ في بقاء الشريعة لا يأتي إلّا من احتمال صدق مدّعي النبوّة الّذي هو المنجّز لوجوب الفحص عن صدقه فلا يكون هو معذوراً إن ترك الفحص ووقع في المخالفة لصدق مدّعي النبوّة واقعاً، نعم، يكون معذوراً إن فحص وحصل له العلم بكذب المدّعي، فما دام احتمال صدق مدّعي النبوّة باقياً لا يكون المکلّف معذوراً، والاستصحاب لا يدفع هذا الاحتمال ولا يؤثّر في نفيه.
وبالجملة: استصحاب بقاء الشريعة السابقة للشكّ فيه من جهة دعوى مدّعي النبوّة لا يدفع احتمال صدقه، ومع بقاء الاحتمال يجب عليه الفحص.
هذا کلّه إذا كان تمسّك الكتابي بالاستصحاب لدفع وجوب الفحص عن صدق مدّعي النبوّة عن نفسه.
وأمّا تمسّكه به قبال المسلم، فإن كان لإثبات صحّة دينه به فقد عرفت أنّه لا يثبت به. وإن كان لجعل کلفة إثبات الإسلام على المسلم قبال الكتابي فليس هو بشيء، لأنّ على کلّ مدّع إثبات دعواه، فعلى مدّعي النبوّة وعلى المسلم قبال الكتابي إثبات الإسلام، وعلى الكتابي أيضاً إن كان يدّعى صحّة عقيدته إثباتها بما يوجب اليقين؛ لا يثبت بالاستصحاب دينه كما لا يثبت به الإسلام للمسلم أيضاً، فتدبّر.
هذا کلّه ما سنح ببالي القاصر.
وأمّا السيّد الاُستاذ فقد أفاد هنا أنّ الاُمور الاعتقادية على أقسام:
فقسم منها: لا يكون حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي مثل وجود الله تعالى وصفاته. نعم، يجب الاعتقاد به وعقد القلب بوجوده، ولكن لا معنى لجريان الاستصحاب فيه باليقين السابق والشكّ اللاحق.
ص: 201
والقسم الآخر: يكون مثل الولاية مجعولاً بجعل إلهي ويتعلّق به العمل بوجوب الإطاعة، ولا مانع من جريان الاستصحاب من تلك الجهة، ولكنّه ممنوع من جهة اُخرى وهي: أنّ الولاية الخاصّة يجب معرفتها بالقطع واليقين ولا معنى للتعبّد بها شرعاً لعدم حصول المعرفة به.((1))
أقول: ويمكن أن يقال: إنّ الولاية المجعولة بالجعل الإلهي الّتي هو الموضوع لوجوب الإطاعة لا يتطرّق الشكّ في بقائها بعد اليقين بها إذا كان الوليّ حيّاً. نعم، يتطرّق الشكّ فيها بالشكّ في بقاء حياته لا مطلقاً.
ثم أفاد بأنّ منها: ما يمكن أن يكون مجعولاً ويمكن أن لا يكون مجعولاً، مثل النبوّة، ولا مانع من جريان الاستصحاب فيها؛ لكونها موضوعاً لوجوب إطاعة النبيّ، ولكنّه أيضاً ممنوع لعين ما ذكر بالنسبة إلى الولاية.((2))
وفيه: أيضاً ما قلناه في الولاية، مضافاً إلى أنّه لم يظهر لنا معنى عدم كون النبوّة مجعولاً، والله هو الهادي.
إعلم: أنّه قد اختلفوا فيما إذا ورد عامّ وخصّص في زمان، فهل يكون المورد بعد هذا الزمان مورداً للاستصحاب أو التمسّك بالعامّ؟ - بعد اتّفاقهم على عدم جريان الاستصحاب مع دلالة العامّ - على أقوال:
الأوّل: أنّه يتمسّك فيه بالعموم مطلقاً. وهو مختار المحقّق الثاني، واختاره سيّدنا
ص: 202
الاُستاذ(قدس سره) على ما حكاه عنه الفاضل المقرّر.((1))
الثاني: أنّ المرجع هو استصحاب حكم المخصّص مطلقاً وعزي اختياره إلى السيّد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه.
الثالث: التفصيل بين ما إذا كان المخصّص لبّياً فيتمسّك فيه بالعامّ، وما إذا كان لفظياً فيتمسّك فيه باستصحاب حكم المخصّص. ونسب هذا القول إلى صاحب الرياض(رحمه الله).
الرابع: التفصيل بين ما إذا كان الزمان مفرّداً فيقال بالتمسّك بالعامّ، وبين ما إذا كان ظرفاً، فالمرجع هو استصحاب حكم المخصّص. وهو مختار الشيخ الأنصاري(قدس سره).((2))
الخامس: التفصيل بين ما إذا اُخذ الزمان قیداً لكلّ من العامّ والخاصّ فالمرجع هو العامّ دون استصحاب الخاصّ.
أمّا عدم جريان استصحاب الخاصّ، فلأنّه كان مقيّداً بالزمان مثل قوله: «أكرم العلماء في کلّ زمان ولا تكرم زيداً العالم في يوم الجمعة» فاستصحاب حرمة إكرامه في يوم السبت يكون من استصحاب حكم موضوع لموضوع آخر، وبطلانه أوضح من أن يخفى، فلا يجوز التمسّك بالاستصحاب ولو لم يكن هنا عامّ في البين.
وأمّا التمسّك بعموم العامّ، فلانحلاله بأحكام متعدّدة متعلّقة بموضوعات متعدّدة لا يخرج بعضها عن العامّ بخروج بعضها، فإذا ثبت تخصيص العامّ بخروج بعض الأفراد عن تحته وشكّ في خروج سائر الأفراد فالشكّ يكون في زيادة التخصيص ومقتضى الأصل عدمه والرجوع إلى العامّ كما هو الحال في صورة الشكّ في أصل التخصيص.
وهكذا إذا اُخذ الزمان قیداً في العامّ وظرفاً للخاصّ، فإنّ في مثله لا شكّ في إجراء
ص: 203
حكم العامّ. ومع قطع النظر عن العامّ يكون المرجع استصحاب حكم الخاصّ، إلّا أنّه لا مجال له مع وجود العامّ. ففي هاتين الصورتين يكون الحكم الرجوع إلى العامّ.
وبين ما إذا کان الزمان مأخوذاً ظرفاً للحكم في العامّ وقيداً في الخاصّ، لأنّ فيه لا مجال للتمسّك بالعامّ الّذي كان مفاده ثبوت الحكم بنحو الدوام والحال أنّه انقطع بالخاصّ وقطع استمراره ولا يكون متكفّلاً لبيان حكم المورد بعد انقطاعه، كما لا يجري استصحاب الحكم المخصّص، فلابدّ من الرجوع إلى سائر الاُصول.
وكذا إذا كان الزمان ظرفاً في کلّ واحد من العامّ والخاصّ، فلا يجوز التمسّك بالعامّ لانقطاع استمراره بالخاصّ، ولكن يكون المرجع هو استصحاب حكم الخاصّ.
فهاتان الصورتان مشتركتان في عدم جواز الرجوع إلى العامّ، غير أنّ المرجع في الصورة الاُولى يكون غير الاستصحاب من سائر الاُصول، وفي الثانية يكون المرجع استصحاب الخاصّ. وهذا ما اختاره المحقّق الخراساني، ولكنّه استدرك عن الحكم في الصورة الأخيرة ما إذا ورد التخصيص على العامّ من أوّله كما إذا قال: «أنفق في سبيل الله في تمام هذه السنة»، ثمّ قال: «لا تنفق على زيد في أوّل ساعة من السنة»، فقال بجواز التمسّك بالعامّ لوجوب الإنفاق فيما بعد الساعة الاُولى من الساعات، بخلاف ما إذا قال: لا تنفق عليه في الشهر الثاني مثلاً.
والوجه في هذا التفصيل عنده: أنّ في الأوّل لم ينقطع الحكم حتى لا يمكن التمسّك بالعامّ، لأنّ أوّل زمان وجوده المستمرّ بعد الزمان الأوّل الّذي دلّ الخاصّ على خروجه عن تحت العامّ، دون الثاني. وبنى على ذلك جواز التمسّك ب- ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾((1)) لو خصّص بخيار المجلس أو خيار الحيوان، دون الثاني فإنّه ينقطع به حكم العامّ.((2))
ص: 204
وعلى هذا، الفرق بين ما اختاره الشيخ وصاحب الكفاية فيما إذا كان الزمان ظرفاً في کلّ من العامّ والخاصّ صار مختار الشيخ عدم جواز التمسّك بالعامّ مطلقاً واستصحاب حكم المخصّص، ومختار صاحب الكفاية التفصيل بأن لا يجوز التمسّك بالعامّ إذا ورد التخصيص في الأثناء دون ما إذا كان وارداً في الابتداء. ولا يجري الاستصحاب إذا كان الزمان قیداً للخاصّ.
وربّما يورد عليهما بأنّ الزمان إذا لم يؤخذ مفرّداً في العامّ كقوله: «أكرم العلماء» من غير تقييد بمثل قوله: «في کلّ زمان» أو «في کلّ يوم» فإكرام العلماء إمّا يكون عبرة لكل من أفراد إكرامهم على نحو العامّ الاستغراقي فيدلّ بالعموم على وجوب إكرام کلّ فرد من العلماء، كما يدلّ بالإطلاق على وجوب کلّ فرد منهم حسب جميع حالاته الطارئة، فإذا خرج فرد منه في حال من حالاته وشكّ في شمول دليله لسائر حالاته يتمسّك بإطلاق العامّ للحكم عليه بالعامّ.
وبعبارة اُخرى يتمسّك بعموم العامّ للحكم على أفراد العامّ، ولحالات الأفراد بإطلاق الإكرام.
وإمّا يكون الإكرام موضوعاً للعامّ على نحو الطبيعة السارية في الأفراد بأن يكون کلّ فرد من أفراد الإكرام مصداقاً وفرداً لها من غير أن يكون کلّ واحد من المصاديق ملحوظاً مستقلّا ولكنّه يكون بحيث لو خالف المکلّف في بعض المصاديق ولم يأت به لا يسقط عنه وجوب الإتيان بسائرها، وفي مثل هذا أيضاً كما يكون إكرام کلّ فرد من أفراد العلماء مصداقاً لطبيعة الإكرام السارية في جميع الأفراد بقوله: «أكرم العلماء» أو «أوفوا بالعقود» يكون کلّ فرد منه في کلّ حال من أحواله مصداقاً للإكرام والوفاء.
فعلى هذا، يمكن أن يقال: بورود الإشكال على الشيخ القائل بعدم جواز الرجوع
ص: 205
إلى العامّ إذا كان الزمان ظرفاً للعامّ، وكذا على صاحب الكفاية القائل بالتفصيل المذكور، فيجوز التمسّك بإطلاق موضوع دليل العام.
اللّهمّ إلّا أن يقال: معنى كون الزمان ظرفاً للعامّ أنّ مثل الوفاء في مثل «أوفوا بالعقود» يكون أمراً بسيطاً في وعاء الزمان بحيث لو خولف في زمان من الأزمنة سقط الأمر به بالعصيان، وفي مثله إذا خصّص بزمان لا يمكن التمسّك بالعامّ لوجوبه في سائر الأزمنة لقطع حكمه به، فتأمّل.
هذا، وقد أفاد السيّد الاُستاذ - طاب الله مضجعه - بعد بيان ما أفاد اُستاذه صاحب الكفاية: ما يوافق حاصل ما ذكرناه من التمسّك بالعامّ مطلقاً، وعدم جواز التمسّك بالاستصحاب وإن كان الزمان ظرفاً للعامّ بتقريب: أنّه لا شكّ في وجوب التمسّك بالعامّ إذا كان کلّ زمان من الأزمنة مفرّداً لموضوعه وخرج منه بعض أفراده في زمان من الأزمنة وشكّ في حكم ذلك الفرد بعد هذا الزمان، لأنّ مثل «إكرم العلماء» - باعتبار كون الزمان مفرّدا له - يتكثّر وينحلّ بموضوعات متكثّرة كما ينحلّ الحكم أيضاً به بأحكام كثيرة. فإذا ورد دليل خاصّ على عدم إكرام زيد في زمان خاصّ لا ريب في أنّه يتمسّك بالعامّ في وجوب إكرام زيد في غير هذا الزمان، كما يتمسّك به في وجوب إكرام غير زيد من أفراده العرضية.
وإذا كان العامّ مقيّداً بالدوام كقوله: «أكرم العلماء دائماً» يكون موضوع کلّ حكم - من الأحكام الّتي انحلّ العامّ بها - الإكرام الدائم له في جميع حالاته وفي جميع الأزمنة على سبيل العامّ المجموعي، بمعنى أنّ المولى اعتبر مجموع الإكرامات المستمرّة المتتالية شيئاً واحداً وأمر بها نظير المركّب. وكما إذا قال: «أكرم هذه الفئة» أو «أعتق هذه العشرة». فإذا قال: «لا تكرم زيداً العالم في يوم الجمعة» يكون دليلاً على خروج زيد عن تحت «أكرم العلماء يوم الجمعة» وساكتاً عن حكمه بعد يوم الجمعة فيبقى ما بعد
ص: 206
يوم الجمعة تحت العامّ، فإذا كان العامّ ملحوظا على سبيل العامّ المجموعي فكما يشمل أفراده العرضية بعد خروج فرد منه كذلك يشمل أفراده الطولية بعد خروج فرد منها.
وبعبارة اُخرى: يكون مفاد العامّ مطلوبية مجموع الإكرامات، ومفاد الخاصّ خروج مقدار منها عن المطلوبية، فيبقى غيره باقياً على مطلوبيته. إذن: لا فرق بين هذه الصورة والصورة الاُولى إلّا في كون الخارج في الأوّل الفرد، وفي الثاني البعض أي بعض المجموع.
وهنا قسم ثالث، وهو: ما إذا لم يكن مقيّداً بالزمان أصلاً لا على كون التقيّد به مفرّداً، أو مستمرّاً، مثل قوله: «أكرم العلماء».
ففيه: إن كان العامّ دالّا على مطلوبية الإكرام في الجملة ولم يكن له إطلاق، يكون مفاده في مثل «أكرم العلماء» إكرام کلّ فرد منهم في الجملة، فإذا دلّ دليل الخاصّ على عدم مطلوبية إكرام زيد مثلاً في يوم الجمعة لا يكون مانعاً من التمسّك بالعامّ لمطلوبية غيره في الجملة. ولا يكون معارضاً للعامّ في أصل المطلوبية في الجملة، بل يكون مبيّناً للدليل ورافعاً لإجماله.
وإن كان له إطلاق بحسب الزمان، فلا يخلو إمّا أن يستفاد من الإطلاق مطلوبية کلّ فرد منه على حدة بحيث يكون إكرام کلّ يوم فرداً من العامّ فيكون إطلاقه راجعاً إلى الأوّل يتمسّك به في غير يوم الجمعة، أو يستفاد منه المطلوبية على الدوام والاستمرار فيكون إطلاقه راجعاً إلى الثاني ويعامل معه معاملة العامّ المجموعي، كما قد عرفت.
فإن قلت: المستفاد من تقيّد العامّ بالدوام اتّصال مطلوبية الإكرام على الدوام، فإذا انقطع الاتّصال بالدليل لا يبقى مجال للتمسّك بالعامّ فنحتاج إلى دليل آخر دالّ على مطلوبية الباقي من العامّ تحت الحكم بعنوان آخر.
قلت: مدلول العامّ المقيّد بالدوام والاستمرار هو الاتّصال والمتصل بالحمل الشائع
ص: 207
لا الحقيقي وهو العامّ المجموعي، وليس عنوان الاتّصال مأخوذاً في موضوعه ولا يستظهر ذلك من لفظ الدوام والاستمرار، بل يمكن دعوى ظهوره في خلافه.
هذا، ولا يخفى عليك: أنّ ما ذكر يكون فيما إذا كان الدوام قیداً للواجب.
وأمّا إذا كان قیداً للوجوب - كما هو الظاهر من الكفاية فإنّه جعل الدوام قیداً للحكم، ومعنى تقييده بالدوام أنّه لا ينسخ إلى الأبد وإن كان المطلوب من متعلّقه إيجاد نفس الطبيعة الّذي يحصل بوجود فرد منها - فالحكم أيضاً في غير مورد الخاصّ هو التمسّك بالعام، لدلالة العامّ على بقاء الحكم في غير مورد الخاصّ، كما عرفت ذلك، بالإضافة إلى كون الدوام والاستمرار قیداً للموضوع، فتدبّر وراجع التقريرات((1)) لعلّك تستفيد منه ما هو أزيد ممّا قلناه، والله هو الهادي إلى الصواب.
لا ريب في أن المستفاد من أخبار الباب: أنّ الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو خلاف اليقين، يشمل الشكّ المصطلح والظنّ بالخلاف وكذا الظنّ بالوفاق بطريق أولى.
فلا حاجة مع مثل قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «ولكن تنقضه بيقين آخر» إلى دليل آخر مثل دعوى الإجماع القطعي((2)) على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف.
أو أن يقال:((3)) إنّ الظنّ غير المعتبر إن علم عدم اعتباره بالدليل مثل الظنّ الحاصل من القياس فوجوده كعدمه عند الشارع فكلّما يترتّب على
ص: 208
تقدير عدمه يترتّب على تقدير وجوده، وإن كان اعتباره مشكوكاً فيه فالبناء عليه ورفع اليد عن اليقين السابق به يكون من نقض اليقين بالشكّ.
أمّا دليل الإجماع فيرد عليه صغروياً وكبروياً.
وأمّا الدليل الثاني، ففيه أنّ عدم اعتبار الظنّ بالدليل، أو عدم الدليل على اعتباره لا يفيد إلّا عدم إثبات مظنونه به تعبّداً فلا تترتّب عليه آثاره شرعاً ولا يفيد ترتّب آثار الشكّ عليه إذا لم يكن الشكّ المذكور في الأخبار أعمّ من الظنّ، بل لابدّ حينئذٍ من الرجوع إلى سائر الاُصول كأصل البراءة من التكليف أو أصالة الطهارة، والله هو العالم.
إعلم: أنّه قد ذكر في الكفاية أنّه لابدّ في الاستصحاب من أمرين:
أحدهما: بقاء الموضوع والثاني عدم أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه. فيقع الكلام في مقامين:
قال الشيخ: إنّ المراد بالموضوع معروض المستصحب، مثل زيد المعروض للقيام مثلاً.
والمراد ببقائه بقاؤه على النحو الّذي كان في السابق معروض المستصحب إمّا بتقرّره الذهني أو بوجوده الخارجي، ففي الشكّ في قيام زيد لابدّ من بقاء زيد في الزمان اللاحق خارجاً كما كان في السابق وجوده محقّقاً محرزاً. وفي استصحاب وجود زيد يكفي تقرّره في الذهن، فكما كنّا نحكم بوجود زيد في الخارج وكان الموضوع زيد المتقرّر في الذهن إذا شككنا في بقاء وجوده نحكم عليه بالبقاء.
وبعبارة اُخرى: إذا كان المتيقّن السابق من عوارض شيء خارجيّ كقيام زيد وشككنا في بقاء قيامه يجب في الحكم ببقاء قيامه بحكم الاستصحاب بقاء زيد الّذي
ص: 209
هو معروض المستصحب وهو الموضوع. وإذا كان المتيقّن السابق عين أمر خارجي مثل وجود زيد وحياته وشككنا في بقائه لا يعتبر في استصحابه بقاؤه لمنافاة الشكّ في بقائه مع العلم بوجوده، بل يكفي بقاؤه في الذهن، وإليك ما أفاده الشيخ بلفظه:
الأوّل: بقاء الموضوع في الزمان اللاحق والمراد به معروض المستصحب، فإذا اُريد استصحاب قيام زيد أو وجوده فلابدّ من تحقّق زيد في الزمان اللاحق على النحو الّذي كان معروضاً في السابق، سواء كان تحقّقه في السابق بتقرّره ذهناً أو بوجوده خارجاً، فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي، وللوجود بوصف تقرّره ذهناً لا وجوده الخارجي. (إلى أن قال:) ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط (يعني بقاء الموضوع) في جريان الاستصحاب واضح؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لاحقاً فإذا اُريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به فإمّا أن يبقى في غير محلّ وموضع وهو محال، وإمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، ومن المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقاً بالعدم فهو المستصحب دون وجوده. انتهى.((1))
والجواب عنه أنّه لا دليل على لزوم ما ذكر، أي إحراز معروض المستصحب خارجاً.
وأمّا الاستدلال عليه بلزوم انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر وهو غير معقول، وأن يكون الحكم بالحدوث لا بالبقاء، أو لزوم كون العرض بدون المعروض وهو محال.
ففيه: أنّ ذلك يتمّ بالنسبة إلى وجود العرض الحقيقي الخارجي، وأمّا بالنسبة إلى وجوده التنزيلي والبنائي التعبدي فلا مانع منه لتوسعة دائرة التعبّد والبناء.
ص: 210
هذا، وأمّا صاحب الكفاية فقد أفاد في هذا الشرط:((1)) أنّ معنى اعتبار بقاء الموضوع اتّحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة موضوعاً، كاتّحادهما حكماً؛ لأنّ بدونه لا يكون الشكّ في البقاء بل يكون في الحدوث، ولا يكون رفع اليد عن اليقين في محلّ الشكّ نقض اليقين بالشكّ، بل هذا الاتّحاد ليس شرطاً زائداً على أصل تحقّق موضوع الاستصحاب، فالاستصحاب مركّب من القضيتين المتحدّتين موضوعاً ومحمولاً.
وإنّما الكلام في أنّ الاتّحاد المذكور هل يكون بنظر العرف أو العقل؟ أو بحسب دليل الحكم؟
فإن كان بنظر العقل يلزم منه عدم جريان الاستصحاب في الأحكام في کلّ مورد شكّ في بقاء الحكم، لزوال خصوصية كانت في الموضوع أو زيادة خصوصية لم تكن فيه.
وإن كان بحسب لسان الدليل والجمود عليه يلزم الاقتصار على جريان الاستصحاب بنفس العنوان المذكور في لسان الدليل وإن علم كونه مشيراً إلى ما هو الموضوع واقعاً فإذا قال: أكرم هذا القاعد أو النائم، ثم زال عنوان القائم أو القاعد وشكّ في بقاء الحكم لا يجري استصحاب وجوب إكرامه، لزوال الموضوع المأخوذ في لسان الدليل مع أنّه يجري فيه الاستصحاب بلا کلام.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد أنّه يعتمد على لسان الدليل إذا كان استظهار كون العنوان فيه مشيراً مورداً للشكّ، لا ما إذا كان مثل هذا المثال أو مثل: «العنب إذا غلى يحرم».
وبالجملة: فالاعتبار على لسان الدليل إذا لم يكن بنظر العرف موضوع القضيتين واحداً أو كان مورد الشكّ وإلّا لا ريب في أنّ المعيار في تشخيص هذا الاتّحاد هو العرف، لأنّه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية الّتي منها الخطابات الشرعية، والله هو العالم.
ص: 211
إعلم أنّه قد ذكر المقرّر الفاضل(قدس سره) حكاية عن السيّد الاُستاذ(قدس سره) ذهاب البعض إلى جريان الاستصحاب في مورد قيام الأمارة.((1)) ولم يشر إلى اسمه.
وهذا غريب بعيد، لأنّ القول به على الإطلاق يوجب سقوط أكثر أدلّة الأحكام الفرعية - المبتنية على أخبار الآحاد - عن دلالتها عليها، وتعطيل الأحكام. وكذلك يوجب سقوط البيّنة في الموضوعات، مع أنّ مدار الاُمور يكون عليها وهي من الأمارات.
وكيف كان، كما أفاد صاحب الكفاية، لا شبهة في عدم الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده،((2)) ولا يحتاج ذلك إلى كثير تحقيق.
وإنّما الكلام يقع في أنّ عدم جريانه مع قيام الأمارة هل يكون للتوفيق بين دليل اعتبار الأمارة وخطابه؟ بتقريب: أنّ العرف يفهم من الدليلين معنىً مناسباً لهما، كالتوفيق بين دليل حجّية الأمارات والاستصحاب، لما ذكر من ابتناء أخذ أحكام الشرع بأخذها من الأمارات ومعرفة الموضوعات على البينة. فلابدّ من كون أمر آخر حجّة أن يكون في طولها لا نافياً لها أو لأكثرها.
أو أنّه للحكومة؟((3)) فإنّها عبارة عن حكم الشارع في ضمن دليل برفع اليد عمّا يقتضيه دليل آخر.
وبعبارة اُخرى الحكومة عبارة عن: كون أحد الدليلين شارحاً وناظراً إلى الآخر، فإذا قال الشارع: «إعمل بخبر الثقة الواحد في الأحكام»، أو قال: «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك»، معناه: إرفع اليد عن آثار احتمال المخالف لذلك، مثل استصحاب العدم أو
ص: 212
استصحاب الطهارة، واعمل معاملة النجاسة معه. فمثل قوله: «اعمل بالبيّنة» يكون مبيّناً لمقدار دلالة دليل الاستصحاب ومضيّقاً لدائرته، فإنّ دليل الحاكم تارة يكون مضيّقاً لدائرة موضوع المحكوم مثل: «أكرم العلماء» و«زيد ليس من العلماء» بلحاظ نفي حكم وجوب الإكرام عنه مع كونه عالماً حقيقة، فيكون حاكماً على «أكرم العلماء». والمثال الآخر قوله: «لا شكّ لكثير الشكّ». واُخرى يكون موسّعاً لها كقوله: «زيد من العلماء» بلحاظ إثبات حكم وجوب الإكرام عليه مع عدم كونه من العلماء.
أو يكون عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة للتخصّص؟ وهو: خروج فرد عن موضوع الحكم عقلاً وواقعاً. ولا ريب أنّ الاستصحاب في مورد الأمارة ليس خارجاً عن الدليل الدالّ عليه بالعموم عقلاً وواقعاً.
أو يكون بالتخصيص؟ وهو: إخراج بعض الأفراد عن تحت الحكم مع كونه داخلاً في الموضوع مثل: «أكرم العلماء» و«لا تكرم زيداً العالم».
والأقوى أنّ عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة ليس من التخصيص - وإن نسب اختياره إلى جماعة - ، أي ليس دليل الأمارة مخصِّصاً لدليل الاستصحاب وإخراجاً لموردها عن حكم الاستصحاب، لكون دليل الأمارة أعمّ من الاستصحاب كما أنّ دليل الاستصحاب أيضاً أعمّ من مورد البراءة، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه فيتعارضان في مادّة الاجتماع.
أو يكون بالورود؟((1)) وهو: كون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الحكم المذكور في الدليل الآخر حقيقة كما هو كذلك في الأمارات والاُصول العقلية، كالبراءة العقلية والاحتياط والتخيير العقليين، فإنّ مع قيام الأمارة على حكم أو موضوع ذي حكم لا يبقى مجال لإجراء الاُصول المذكورة.
ص: 213
أو تعبّداً، كالأمارة قبال الاُصول الشرعية، والاستصحاب بناءً على كونه من الاُصول العملية، وقاعدة الحلّيّة والطهارة؛ فإنّ الأمارة إذا قامت تكون رافعة - تعبّداً وشرعاً - للجهل أو الشكّ في موارد الاُصول المذكورة.
هذا، وقد أفاد السيّد الاُستاذ(قدس سره): بأنّ التحقيق ما اختاره اُستاذه صاحب الكفاية من أنّ عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة يكون للورود، لأنّ رفع اليد عن اليقين السابق بسبب الأمارة ليس نقضاً لليقين بالشكّ بل باليقين.
وليس بالتخصيص، لأنّه لا وجه له (وقد عرفت ما هو الوجه له والجواب عنه). ولا بالحكومة، لأنّه لا نظر لدليل الأمارة إلى مدلول دليل الاستصحاب بما هو مدلوله في مقام الإثبات وإن كان معنى لزوم العمل بالأمارة إلغاء احتمال الخلاف في مقام الثبوت.
والحاصل: مقتضى: دليل الأمارة هو: وجوب العمل على طبقها في حال الشكّ، كما هو مقتضى دليل الاستصحاب، لا أنّ مقتضاه إلغاء احتمال الخلاف حتى يكون ناظراً إلى دليل الاستصحاب ومدلوله.((1)) انتهى. والله هو العالم.
ص: 214
إعلم: أنّه قد أفاد في الكفاية في بيان النسبة بين الاستصحاب والاُصول العملية: أنّها بعينها هي النسبة بين الأمارات وبينه،((1)) فيكون الاستصحاب مقدّماً على هذه الاُصول، وإلّا يلزم في النقلية منها - كالبراءة الشرعية من تقدّمها على الاستصحاب - إمّا تخصيص دليله بدون المخصّص، أو القول بكون المخصّص لدليله دليل البراءة الشرعية وهو مستلزم للدور؛ لأنّ كونه مخصّصاً لدليل الاستصحاب يتوقّف على اعتباره مع الاستصحاب، واعتباره معه يتوقّف على كونه مخصّصاً له. وعلى هذا، يكون الاستصحاب وارداً على البراءة الشرعية بالورود التعبّدي، بمعنى كونه رافعاً للشكّ أو الاحتمال الّذي هو موضوع البراءة بحكم الشرع تعبّداً لا حقيقة فينتفي به موضوع البراءة تعبّداً.
وأمّا الاُصول العقلية فالاستصحاب يقدّم عليها لكونه رافعاً لموضوعها واقعاً وحقيقة، لكونه بياناً في مواردها.
فمثل التخيير العقلي إنّما يكون مرجعاً إذا لم يكن بياناً معيّناً لأحد الطرفين (الحرمة والوجوب)، والاستصحاب بيان للطرف الّذي يقوم عليه.
ص: 215
وکذا یرتفع به موضوع البراءه العقلیه وهو عدم البیان.
وموضوع الاحتياط الناشئ من العلم الإجمالي بالتكليف وهو عدم الأمن من العقوبة بالإتيان ببعض الأطراف دون البعض، فإذا علم بخمرية أحد الإناءين يجب الاجتناب عنهما، أمّا إذا علم بكون أحدهما سابقاً خمراً والآخر خلّا ينحلّ العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحدهما المعيّن والشكّ في وجوب الاجتناب عن الآخر، بل وإن لم تعلم الحالة السابقة للطرف الآخر.
هذا، وأمّا السيّد الاُستاذ(قدس سره) فيظهر من تقريرات بحثه الشريف: أنّه لا يرى التعارض بين الاستصحاب وسائر الاُصول العملية، فالبراءة العقلية عنده عبارة عن حكم العقل بأنّ مجرّد الاحتمال لا يوجب تنجّز التكليف، ولا ينافي ذلك قيام الحجّة على التكليف، لأنّ تنجّزه بالاستصحاب ليس بمجرّد الاحتمال بل بالحجّة القائمة عليه. وبعبارة اُخرى: مفهوم البراءة العقلية وعدم تنجّز التكليف بمجرّد الاحتمال تنجّزه إذا قامت الحجّة عليه والاستصحاب حجّة عليه.
وأمّا بالنسبة إلى البراءة النقلية، فإن كان مفاد ما يدلّ عليها الإرشاد إلى حكم العقل، وأنّ التكاليف المجهولة مرفوعة عن الاُمّة ولا تصير فعلية، فالكلام فيها هو الكلام في البراءة العقلية. إلّا أنّ ظاهر دليلها بالتدقيق هو التأسيس لا الإرشاد إلى حكم العقل المذكور. وحينئذٍ إن كان مفاد دليلها إخباراً عن عدم جعل طريق منجّز للتكاليف المجهولة، فلا ريب في تعارض دليلها مع دليل الاستصحاب، بل وسائر الطرق والأمارات. لكن هذا أيضاً خلاف الظاهر.
والتحقيق في مفاد دليلها هو: أنّ التكاليف المجهولة بعنوان أنّها مجهولة مرفوعة عن الاُمّة، بمعنى أنّها مع الجهل بها وإن كانت تقتضي جعل الاحتياط إلّا أنّها صارت مرفوعة عن الاُمّة.
ص: 216
وبعبارة اُخرى مفاده عدم جعل الاحتياط في التكاليف المجهولة بما هي مجهولة. وهذا معنى لا تعارض بينه وبين قيام الحجّة على ثبوت التكليف، والاستصحاب وسائر الأمارات حجّة. مع أنّ التكليف المجهول بمجرّد قيام الحجّة عليه يخرج عن عنوان المجهولية.((1))
أقول: ويمكن أن نقول: إنّ دليل البراءة النقلية إنّما ينهض بعد الفحص عن الحجّة على التكليف وعدم الظفر به، سواء كانت الحجّة الاستصحاب أو غيره، فتدبّر.
وهو يتصوّر على وجوه:
أحدها: إذا لم نعلم بعدم انتقاض الحالة السابقة في أحدهما، كما إذا شككنا في بقاء وجوب کلّ من الواجبين، كإكرام زيد وإكرام عمرو، في الشبهة الحكمية. أو شككنا في حياة الغريقين في الشبهة الموضوعية من جهة وقوع التزاحم بينهما في مقام الامتثال، فالحكم فيهما هو الحكم في الواجبين اللذين وقع التضادّ بينهما من جهة عدم قدرة المکلّف بإتيان كليهما، كإكرام زيد وإكرام عمر المعلومين وجوبهما في زمان واحد في نفس المثال.
وبالجملة: حكم هذه الصورة، إن كان بينهما ما هو أهمّ من الآخر يجب الإتيان به، وإلّا فالمكلّف مخيّر بإتيان أيّهما شاء.
ولكن السيّد الاُستاذ كما يستفاد من تقريرات بحثه الشريف اعترض على اُستاذه في فرض التزاحم بأنّه لا مورد للاستصحاب فيه، لأنّ التعارض إذا وقع بين الحكمين - للتضادّ الّذي وقع بينهما في مقام الامتثال - فالحكم هو الأخذ بأهمّ منهما إن كان
ص: 217
أحدهما أهمّ من الآخر، وإلّا فحكمه التخيير بينهما فليس لنا شكّ في وجوب أحدهما إمّا بالخصوص أو لا بالخصوص.
وبعبارة اُخرى: حكم التضادّ الواقع بينهما في مقام الامتثال هو ما ذكر، ولا شكّ في بقاء الحكمين من جهة هذا التضادّ، وإلّا فيمكن أن يقال: إنّ الموضوع المبتلى بالمزاحم غير ما لم يكن مزاحما به وإجراء استصحاب حكم غير المزاحم على المزاحم من إسراء الحكم إلى غير ما هو موضوع له. نعم، إذا كان المقصود من الاستصحاب استصحاب مقتضى الوجوب لاحتمال طروّ مانع آخر (غير التضادّ بين الواجبين الّذي ثبت لكلّ منهما وجود المقتضي حتى في حال التمانع وهو المراد من المتزاحمين)، فهو مع خروجه عن فرض التزاحم، لا يجري إلّا على القول بالأصل المثبت، أي لا يثبت به إلّا أثر عقليّ وهو التزاحم، فتأمّل.
ثانيها: ما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، وكان الشكّ في أحدهما مسببّاً عن الشكّ في الآخر.
وبعبارة اُخرى: كان وجود أحد المستصحبين مسبّباً عن وجود الآخر، مثل طهارة الثوب النجس المغسول في الماء المشكوك بقاء طهارته المعلومة سابقاً، فعلى الحكم بطهارة الماء المذكور بالاستصحاب يحكم بطهارة الثوب المذكور.
ولا شبهة في جريان الاستصحاب في هذه الصورة في السبب فقط، وذلك لأنّ جريانه في المسبّب والحكم ببقائه نجساً نقض لليقين بطهارة الماء سابقاً بالشكّ. بخلاف جريانه في السبب، فإنّ مع جريانه فيه يكون نقض اليقين بنجاسة الثوب والحكم بطهارته نقضاً باليقين وبما هو رافع للنجاسة شرعاً.
وأيضاً إجراء الاستصحاب في المسبّب إمّا يكون مع إجرائه في السبب، وإمّا يكون برفع اليد عن إجرائه فيه، وكلاهما محال.
ص: 218
أمّا الأوّل فلأنّه يستلزم الحكم ببقاء نجاسة الثوب وطهارته.
وأمّا الثاني، فإمّا أن يكون بتخصيص دليل الاستصحاب في السبب بلا مخصّص؛ وإمّا يكون بتخصيصه بالاستصحاب الجاري في المسبّب.
أمّا الأوّل، فبطلانه واضح.
وأمّا الثاني، فمستلزم للدور، لأنّ عدم فردية الاستصحاب الجاري في السبب لدليل الاستصحاب موقوف على فردية الجاري في المسبّب له، وفرديته تتوقّف على عدم فردية الجاري في السبب، وهو دور.
هذا کلّه إذا كان الاستصحاب جارياً في السبب وإلّا إذا لم يمكن إجراؤه فيه، كما إذ اشتبه الماء المغسول فيه الثوب بغيره من جهة وقوع النجاسة في أحدهما، فلا شبهة في أنّه يجري استصحاب بقاء نجاسة الثوب المغسول فيه.
ثالثها: ما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما وكانا عرضيين لم يكن أحدهما في طول الآخر.
فلا يخلو الأمر إمّا أن يلزم من جريانهما المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، كما إذا علم بوجوب أحد الأمرين إجمالاً بعد العلم بعدم وجوبهما سابقاً، وإجراء استصحاب عدم الوجوب في کليهما يوجب مخالفة الوجوب الفعلي المعلوم بالإجمال، ففي هذا يمنع هذا العلم عن جريانهما شرعاً وعقلاً وإن كان المقتضي لإجراء الاستصحاب في مقام الإثبات وهو إطلاق دليله موجوداً إلّا أنّ المانع المذكور يمنع من تأثيره.
وإمّا أن لا يلزم منه ذلك، مثل ما إذا علم إجمالاً بارتفاع وجوب أحد الأمرين بعد العلم بوجوب کليهما سابقاً، فلا يلزم من إجراء استصحاب الوجوب في الطرفين مخالفة للتكليف أصلاً، فليس هنا ما يمنع من تأثير المقتضي، أي إطلاق خطاب «لا تنقض» وشموله لأطراف العلم الإجمالي.
ص: 219
فإن قلت: لا يشمله الخطاب، لأنّ رفع اليد عن الحالة السابقة في الأطراف ليس نقضاً لليقين بالشكّ بل يكون نقضاً لليقين باليقين.
قلت: رفع اليد عن اليقين في کلّ واحد من الأطراف يكون نقضاً لليقين بالشكّ، واليقين الإجمالي لم يتعلّق بواحد من الأطراف بالخصوص حتى يكون رفع اليد عن اليقين السابق المتعلّق به رفعاً باليقين، بل إنّما هو متعلّق بأحد الأطراف لا بعينه بخلاف اليقين السابق والشكّ اللاحق، فإنّهما تعلّقا بأشخاص الأطراف ومصاديقها الخارجية، وخطاب «لا تنقض» ناظر إلى المصاديق الخارجية.
وممّا ذكر يظهر أنّ ما يقال((1)) من أنّ شمول الأخبار لمثل المقام يوجب التناقض في مدلول بعضها، لأنّ قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في ذيل بعض الأخبار: «ولكن تنقضه بيقين آخر» يشمل العلم الإجمالي بارتفاع أحد الأمرين، وهو يناقض قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «لا تنقض اليقين بالشكّ» الشامل للشكّ في بقاء كل فرد من الأطراف على حالته السابقة.
يردّ بأنّ قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «ولكن...» اعتبر بالإضافة إلى متعلّق الشكّ ، وهو كلّ فرد من الأطراف بالخصوص، والعلم الإجمالي متعلّق بشيء آخر وهو عنوان أحد الأطراف لا بعينه. فعلى ذلك، تشمل الأخبار المقام من غير أن يستلزم تناقضاً في البين. فعلى هذا يكون المقتضي - وهو شمول الأخبار - موجوداً، والمانع - وهو لزوم المخالفة العمليّة - مفقوداً.((2))
هذا ما أفاده سيّدنا الاُستاذ أعلى الله مقامه. وأمّا صاحب الكفاية(قدس سره) فكأنّه قبل التنافي بين الصدر والذيل في بعض الأخبار، فلا يتمّ التمسّك بإطلاقه. بيان ذلك: أنّ قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في ذيل بعض الأخبار: «ولكن تنقض اليقين باليقين» يمنع عن دلالة قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في صدرها: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالإطلاق عن النهي عن نقض اليقين بالشكّ في
ص: 220
أطراف العلم الإجمالي لكون اليقين في قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «ولكن...» أعمّ من اليقين التفصيلي والإجمالي. فمفاد المغيّى حرمة النقض في کليهما، والغاية تدلّ وجوبه في أحدهما، فتقع المناقضة بين السلب الكلّي الّذي هو مفاد المغيّى والإيجاب الجزئي مفاد الغاية، فتصير الغاية سبباً لإجمال المغيّى وقرينة على عدم دلالة المغيّى على حرمة النقض في مورد العلم الإجمالي، لكنّه قال: إنّ ذلك لا يمنع من الاستدلال بغيره من الأخبار ممّا ليس فيه هذا الذيل، وشامل لما في أطرافه، لعدم سراية إجمال هذا البعض إلى غيره.((1))
فعلى هذا، مع وجود المقتضي - وهو الإطلاق المذكور وعدم المانع - بلزوم المخالفة العمليّة - يجري الاستصحاب في کليهما. وأمّا المخالفة الالتزامية، فهو ليس بمحذور شرعاً ولا عقلاً.
وممّا ذكر يظهر عدم جريان الاستصحاب في ما إذا يلزم منه المخالفة الاحتمالية وترك الموافقة القطعية، لأنّ إجراءه لا يكون عذراً للمخالفة الإحتمالية إذا وقع فيه، فتدبّر.
إعلم: أنّه كما أفاد في الكفاية،((2)) وأفاد سيّدنا الاُستاذ(قدس سره)،((3)) وغيرهما: لا ريب في تقدّم مثل قاعدة التجاوز، وقاعدة الفراغ، وأصالة صحّة عمل الغير وغيرها من القواعد المقررّة في الشبهات الموضوعية على الاستصحاب الجاري في مواردها - لولا هذه القواعد - المقتضي لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات.
والدليل على ذلك أوّلاً: أخصّية دليل هذه القواعد عن دليل الاستصحاب فيخصّص دليله بأدلّتها.
ص: 221
فإن قلت: قد تكون النسبة بين بعض هذه القواعد ودليل الاستصحاب عموماً من وجه، فلابدّ من القول بتساقط الدليلين بالتعارض، ففي مورد قاعدة اليد إذا احتمل أو علم أنّه ليس ما في اليد مما كان في ملك غير ذي اليد سابقاً حتى تستصحب الملكية السابقة، أو كان ما في اليد ممّا تعاقبت فيه الحالتان، فعلم أنّ ما في اليد كان ملكاً لذي اليد في حالة ولم يكن ملكاً له في حالة اُخرى ولم يعلم السابقة منهما على الاُخرى، ففي هذين المثالين يدٌ ولا استصحاب، فهو مورد الافتراق من جانب اليد، وأمّا مورد الافتراق من جانب الاستصحاب فهو كثير جدّاً. وبالجملة: تكون النسبة بينهما عموماً من وجه، فكيف يقال بأنّ النسبة بينهما الأعمّ والأخصّ المطلق حتى يقال بالتخصيص تحكيماً للخاصّ على العامّ؟!
قلت: قد أجاب في الكفاية((1)) عن ذلك أوّلاً: بالإجماع على عدم التفصيل بين العمل بالقاعدة فيما لم يكن في موردها الاستصحاب، وبين ما إذا كان في موردها.
وثانياً: بأنّ ذلك موجب لقلّة المورد للقاعدة - الّتي تقتضي ملاحظتها وكثرة الحاجة إليها في فصل الخصومات وغيرها حجّيتها مطلقاً - بخلاف العكس، فإنّه لا يوجب قلّة المورد للاستصحاب.
هذا مضافاً إلى أنّه ليس في موارد جريان هذه القواعد ما لم يكن المشكوك فيه مسبوقاً بالعدم، ومقتضى الاستصحاب عدمه؛ ومع ذلك حكم الشارع بوجوده ووقوعه.
نعم، قد استثني من تلك القواعد القرعة، فإنّه لا شبهة في تقدّم الاستصحاب عليها.
أوّلاً: لأخصّية دليله عن دليل القرعة، لأنّ موضوعها الجهل والشكّ، والمعتبر في الاستصحاب الشكّ في ما تكون له حالة سابقة لا مطلقاً.
وثانياً: لقوّة دليل الاستصحاب وضعف دليلها ولو كان من جهة عدم العمل به مطلقاً.
ص: 222
وثالثاً: لعدم حجّية دليل القرعة على الإطلاق، فإنّها مختصّة بالموضوعات دون الأحكام.
ورابعاً: - وهو العمدة - : أنّ الظاهر من أدلّتها أنّها لكلّ أمر مشكل ومشتبه، وما يكون حكمه الواقعي أو الظاهري (والأوّلي أو الثانوي) معلوماً ليس بالمشكل ولا المشتبه. ومثل دليل الاستصحاب وكلّ حكم ظاهريّ يكون رافعاً لموضوعها ومخرجاً لمورده عن تحتها. والله هو العالم بالصواب، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، والحمد لله أوّلاً وآخراً، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
ص: 223
ص: 224
ص: 225
ص: 226
إعلم: أنّه قد أفاد السيّد الاُستاذ((1)) بأنّ أحسن التعاريف وأتمّها في الباب المعنون في کلماتهم بالتعادل والترجيح أو التراجيح هو ما ذكره صاحب الكفاية،((2)) وذلك لأنّه أظهر من أن يبيّن بغير لفظه.
والتعادل والترجيح ظاهر فيما يطرأ على المتعارضين من تعادلهما وكون کلّ واحد منهما عدلاً للآخر، أو ذا مزيّة ورجحان عليه.
فاللازم قبل ذلك تعريف التعارض الواقع بين الدليلين، وهو: يتحقّق بينهما بكونهما متنافيين بحسب المدلول ذاتاً بالتناقض، كما إذا قال: يجب إكرام زید، ولا يجب إكرام زيد؛ أو بالتضادّ، كما إذا قال: يجب إكرام زيد، ويحرم إكرام زيد. أو عرضاً، كما إذا علم إجمالاً بكذب أحدهما.
وهذا إنّما يكون إذا لم يكن أحدهما قرينة على إرادة ما هو خلاف الظاهر من الآخر، وإلّا ينتفي التعارض بينهما. فلابدّ في مقام مقايسة أحد الدليلين مع الآخر من ملاحظة
ص: 227
أنّه هل يكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر من اللفظ الآخر أم لا؟ فإذا كان أحدهما قرينة على ذلك لا يتحقّق التعارض بينهما أصلاً، ولا نحتاج إلى الرجوع إلى الأخبار العلاجية والترجيح والتخيير، وملاحظة فتوى المشهور، وإن كان الدليلان بقطع النظر عن كون أحدهما قرينة على تعيين المراد من الآخر متعارضين، فهذه قاعدة کلّية في باب التعارض. وعلى ذلك، لا يدخل في باب المتعارضين العامّ والخاصّ، والمطلق والمقيد، لكون الخاصّ أو المقيّد بالنسبة إلى العامّ والمطلق نصّاً في الخصوص وقرينة عند العرف على عدم إرادة العموم من العامّ والمطلق.
فلا وجه لما قاله البعض من لزوم ملاحظة فتوى المشهور والأخذ بما يطابقها من العامّ أو الخاصّ.
وذلك لأنّ فتوى المشهور إنّما تلاحظ فيما إذا كان الدليلان متعارضين، ولا يرى العرف تعارضاً بين العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد أصلاً، بل الخاصّ عندهم قرينة على عدم إرادة العموم من العامّ، وهكذا في المطلق والمقيّد.
نعم، إذا لم يكن الخاصّ والمقيّد نصيّن في مدلولهما بل كانا ظاهرين في مدلولهما يدخلان مع العامّ والمطلق في باب التعارض. بل إذا كان العامّ والمطلق - في مورد - بسبب احتفافهما بقرينة أنصّ وأظهر دلالة من الخاصّ والمقيّد يقدمان عليهما، ولا تعارض بينهما أيضاً. ولكن الغالب - إذا كان العامّ والخاصّ مجرّدين عن قرينة تختصّ بموردهما - قرينية الخاصّ والمقيّد، لأنّ الظاهر من العامّ والخاصّ عدم كونهما مراداً للمتكلّم.
وممّا ذكر يظهر عدم التعارض بين الأدلّة المشتملة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأوليّة والأدلّة المتكفّلة لبيان أحكامها بعناوينها الثانوية، مثل الضرر والحرج والعسر والإكراه والاضطرار، فإنّه لا يتحيّر أهل العرف في تقديم الثانية على الاُولى ويرون الثانية قرينة على إرادة ما هو خلاف الظاهر من الاُولى، وتكون الأدلّة
ص: 228
النافية للأحكام الأوّلية حاكمة عليها وناظرة إلى نفي الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية وإن لم تكن ناظرة إلى أدلّتها ومفسّرة وشارحة لها، هذا.
وأمّا حال الأمارات المعتبرة مع مثل الاُصول العملية، فقد يقال: إنّ مع قيام الأمارة لا يبقى مجال للاُصول، ولا يتحيّر العرف في تقديمها عليها وإن كان دليل الأصل قطعيّ الصدور والدلالة ودليل الأمارة ظنّي الصدور والدلالة. والله هو العالم بالصواب.
ثم إنّه لا يخفى عليك: أنّ ما يدخل في باب التعادل والترجيح هو ما إذا كان الدليلان ظنيّ الصدور وقطعيّ الدلالة والجهة، أو مظنون الدلالة فقط، أو مظنون الدلالة والجهة، ففي هذه الصور المرجع هو الأخبار العلاجية. وهكذا إذا كان کلاهما قطعيّ الصدور وكانا قطعياً من حيث الجهة مختلفاً في ذلك، أو كانت الجهة في أحدهما معلوماً دون الآخر، سواء أكان کلاهما قطعي الدلالة أو ظنيّ الدلالة. وإذا كانا قطعي الصدور والدلالة لا ترجيح لأحدهما على الآخر من جهة الصدور، فهو خارج من باب التعارض المصطلح، فإن أمكن الجمع بينهما عرفاً بحيث يخرجان به عن باب التعارض فهو، وإلّا فالحكم هو التخيير عقلاً.
ص: 229
ص: 230
في حكم المتعارضين
إعلم: أنّ الكلام في حكم المتعارضين يقع في مقامين:
الأوّل: في حكم العقل فيه مع قطع النظر عن الإجماع والأخبار العلاجية.
الثاني: في حكمه بالنظر إليهما. ويأتي الكلام في المقام الثاني إن شاء الله تعالى.
وأمّا الكلام في المقام الأوّل، فاعلم: أنّه يستفاد من تقريرات سيّدنا الاُستاذ أعلى الله مقامه أنّهم قد ذهبوا فيه إلى أقوال:((1))
الأوّل القول بأنّ مقتضى التعارض التساقط والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل. والثاني: القول بالتخيير في العمل بكلّ واحد منهما.
والثالث حجّية أحدهما بلا تعيين ولا عنوان لا واقعاً ولا ظاهراً.
والفرق بينها في مقام العمل وجوب العمل على ما يقتضيه الأصل على القول الأوّل وإن كان مخالفاً لكلّ واحد من المتعارضين.
وعلى القول الثاني، يجب العمل على طبق الأصل الموافق لأحدهما، وذلك لاستقلال العقل بوجوب الأخذ بالدليل الّذي يوافقه الأصل تعييناً.
ص: 231
وعلى الثالث لا يجوز طرحهما والعمل على خلافهما، ولكن يجوز العمل على طبق الأصل المخالف لأحدهما إذا لم يكن معارضاً بالأصل الآخر.
وأمّا الفرق بينها بحسب الوجه: أنّ التعارض مانع عن شمول أدلّة حجّية الخبر لكليهما. وشمولها لواحد من الدليلين دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، لوجود شرائط الحجّية في کليهما على السواء. وشمولها لأحدهما لا بالخصوص بل بلا عنوان، فرع كون ذلك من مصاديق ما دلّ الدليل على حجّيته من الخبر، ومن المعلوم أنّ مصاديقه هي الأفراد الخارجية لا عنوان أحدهما، فإنّه ليس فرداً خارجياً للخبر، والتخيير إنّما يصحّ لو كان أحدهما بالخصوص حجّة واقعية ولا نعلمه بعينه، فإنّ العقل يحكم حينئذٍ بالتخيير مع عدم مرجّح في البين، ولكنّ القول بحجّية أحدهما واقعاً ترجيح بلا مرجّح.
فتحصّل من ذلك کلّه أنّ التعارض موجب لتساقط الدليلين عن الحجّية، فلابدّ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل. هذا کلّه بيان وجه الفرق بين القول الأوّل وغيره.
وأمّا وجه الفرق بحسب الثاني: أنّ دليل الحجّية بإطلاقه يشمل الخبرين، ومقتضاه الأخذ بهما، إلّا أنّ مقتضى التعارض والعلم بكذب أحدهما هو سقوط أحدهما عن الحجّية دون الآخر، ومع الجهل بخصوص ما هو الساقط عن الحجّية،
ص: 232
إلّا أنّه ليس كذلك، أي ليس بحجّة في خصوص مؤدّاه، وأمّا بالنسبة إلى نفي الثالث يكون أحدهما حجّة. وعلى هذا، لا يشمل دليل الحجّية کلّ واحد من المتعارضين، ولا أحدهما المعين، ويشمل أحدهما من غير تعيين ولكنّه لا يفيد حجّية واحد منهما بالخصوص، إلّا أنّه ينفي الثالث به، كما لا يخفى، هذا.
وقد أفاد السيّد الاُستاذ(قدس سره) بعد بيان الفرق بين هذه الأقوال عملاً ووجهاً أنّ التحقيق في المقام يحتاج إلى بسط الكلام وذكر أنّ ما يكون المنشأ للتعارض على ثلاثة أقسام:
الأوّل: أن يكون التنافي بين مدلولي الدليلين ذاتاً وعقلاً بحيث لا يمكن اجتماعهما وثبوتهما معاً لاتّحاد موضوعهما، كما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء والآخر على حرمته.
والحكم في ذلك: امتناع شمول أدلّة الحجّية لهما معاً ذاتاً لا لأمر خارج عنهما؛ لاستلزام ذلك التناقض، لأنّ مقتضى حجّية کلّ واحد منهما تنجّز الواقع به في صورة المصادفة وكونه عذراً له في صورة الخطأ، فإذا كان الواقع مثلاً وجوب ما دلّ عليه أحد الدليلين، فمقتضى حجّية دليل الآخر الدالّ على حرمته أنّه لو تركه مع عدم كونه حراماً وكونه واجباً في الواقع أن يكون معذوراً في تركه، مع أنّ مقتضى دليل حجّية ما دلّ على وجوبه كونه مستحقّاً للعقاب بتركه، وهذا تناقض ظاهر لا يمكن الجمع بين استحقاق العقوبة وعدمه. وهكذا لو كانت المصادفة في طرف الحرمة.
بل يمكن أن يقال: إنّ أدلّة حجّية الأمارات لا تشمل المتعارضين بنفسها وبما هي هي لا لاستلزام شمولها لهما التناقض، لأنّ مفاد حجّية الأمارة هو البعث إلى الأخذ بها وإن كان بعثاً طريقياً، ولا يمكن اجتماع البعث إلى المتعارضين مع عدم إمكان الجمع بينهما.
هذا کلّه بالنسبة إلى شمول الأدلّة لكليهما. أمّا شمولها لأحدهما، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
القسم الثاني: ما إذا لم يكن بين المتعارضين تنافياً ذاتاً، بل وقع التعارض بينهما لأمر
ص: 233
خارجيّ مثل العلم بكذب أحدهما لا على التعيين، وذلك يفرض في الموضوعين، كما إذا دلّ دليل على وجوب صلاة الظهر ودليل آخر على وجوب صلاة الجمعة، أو دلّ دليل على وجوب فعل ودليل آخر على حرمة فعل آخر وعلمنا بكذب أحدهما.
والحكم في ذلك: عدم التنافي بين حجّيتهما معاً لا ذاتاً، لإمكان اجتماع وجوب الظهر ووجوب الجمعة ووجوب فعل وحرمة فعل آخر، وإمكان الجمع بينهما. ولا عرضاً، لأنّ العلم بكذب واحد منهما لا على التعيين لا يمنع من شمول أدلّة الحجّية لكلّ واحد منهما بالخصوص، لأنّ أدلّتها تدلّ على حجّية الأفراد والمصاديق الخارجية المحتمل فيها الكذب والخطأ، ومن المعلوم أنّ احتمال الكذب لا يوجب عدم شمول الأدلّة، بل مفادها إلغاء احتمال الكذب والبناء على الدليل، ولولا ذلك لما يبقى مورد لشمول الأدلّة له لوجود احتمال الكذب في الجميع على السواء، وما تعلّق به العلم الإجمالي - وهو عنوان أحدهما - خارج عن تحت أدلّة الحجّية الدالّة على حجّية الأفراد والمصاديق.
هذا، وقد أورد المقرّر على سيّدنا الاُستاذ: بأنّ ما ذكر من التفصيل إنّما يتأتّى إذا كان دليل حجّية الأمارة الآيات والأخبار. وأمّا إذا كان الدليل بناء العقلاء - وكانت الآيات والأخبار الصادرة إمضاءً للبناء المذكور - فلا وجه لهذا التفصيل، فإنّ بناء العقلاء لا يكون على العمل بالمتعارضين مطلقاً إذا لم يكن لأحدهما مرجّح في البين على الآخر.
ولو تنزّلنا عن ذلك نقول: لم يثبت بناء العقلاء على الدليلين المتعارضين وإن لم يكن التنافي بينهما ذاتياً بل كان عارضياً، إلّا إذا كان کلّ واحد منهما مؤدّياً إلى التكليف وكان کلّ واحد من التكليفين مقدوراً للمكلف.((1))
ص: 234
أقول: لم نتحصّل ورود إيراده بعد الاستثناء الّذي ذكره في آخر كلامه، فتأمّل.
القسم الثالث: ما كان منشأ تعارض الدليلين عدم قدرة المکلّف على امتثالهما معاً، فلا يمكن تنجّزهما فعلاً بحيث يكون المکلّف مستحقّاً للعقاب على مخالفتهما.
ويمكن أن يقال: إنّ مقتضى إطلاق دليل الحجّية هو حجّية کلّ واحد منهما، غاية الأمر أنّ عدم قدرة المکلّف على الامتثال مانع عن تنجّزهما معاً، ولكن لا يمنع عن تنجّز التكليف بهما في الجملة فيجب عليه الإتيان بأحدهما والموافقة الإجمالية دون التفصيلية، لعدم قدرته عليها.
ولا يخفى عليك: أنّ الصحيح هنا التعبير بالموافقة الإجمالية والموافقة التفصيلية لا الموافقة الاحتمالية وحرمة المخالفة القطعية، لأنّ في المتزاحمين بالنسبة إلى ما يختار منهما ممتثل بالموافقة القطعية وبالنسبة إلى الآخر يكون معذوراً في المخالفة القطعية.
نعم، إذا تردّد التكليف بين أحد المتزاحمين تتحقّق المخالفة القطعية بتركهما معاً والموافقة الإحتمالية بفعل أحدهما. فما في التقريرات((1)) من التعبير بوجوب الموافقة الاحتمالية وحرمة المخالفة القطعية كأنّه ليس بمستقيم، فإنّ هذا غير ما جعله نظيراً لذلك في بحث البراءة في مسألة العلم الإجمالي بمتعلّق التكليف وكونه مردّداً بين شيئين لا يمكن الإتيان بهما معاً، هذا.
إذا عرفت ذلك عرفت أيضاً أنّ مقتضى الأصل في القسم الأوّل التساقط، وفي الثاني حجّية کلّ واحد من المتعارضين، وفي الثالث حجيتهما في الجملة. ففي الأوّل لابدّ في مقام العمل الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل. وفي الثاني العمل على طبق المتعارضين. وفي الثالث الموافقة القطعية الإجمالية. وبعبارة اُخرى: العمل على طبق أحدهما على سبيل التخيير إن لم يكن لأحدهما مرجّح على الآخر.
ص: 235
وأمّا القول بأنّ الأصل في المتعارضين التخيير بمعنى حجّية أحد المتعارضين على سبيل البدلية، فلا وجه له.
وهكذا القول بأنّ الأصل حجّية عنوان أحدهما من غير تعيين وهو مختار صاحب الكفاية؛((1)) فباطل، لأنّ أدلة حجّية الأمارات إنّما تدلّ على حجّية کلّ فرد من أفراد الخبر تعيينا، وليس فيها ما يدلّ على حجّية أفرادها تخييراً.
هذا کلّه بناءً على كون حجّية الأمارات من باب الطريقية.
وأمّا بناءً على كونها من باب السببية والموضوعية، فإن قلنا بأنّ المستفاد من دليل الحجّية حجّية خصوص ما لم يعلم كذبه، وبعبارة اُخرى: ما لم يقع التنافى بينه وبين غيره، فلا ريب في أنّه هو الحجّة، كما هو كذلك بناءً على الطريقية، فما علم بكذبه والتنافي بينه وبين غيره ليس بحجّة، وذلك لأنّ هذا هو القدر المتيقّن من دليل الاعتبار، أي بناء العقلاء وظاهر الآيات والأخبار.
وأمّا إن قلنا بشموله لما علم كذبه إجمالاً مثل المتعارضين، فإمّا أن يكون مؤدّى کلّ واحد منهما حكماً إلزامياً في موضوع واحد، كوجوب شيء أو حرمته، فيدخل في باب التزاحم. وحكمه: إن لم يكن أحدهما الأهمّ أو محتمل الأهمّية التخيير، وإلّا فيؤخذ بالأهمّ أو محتمل الأهميّة.
وأمّا إن كان مؤدّى أحدهما الحكم الإلزامي، كالوجوب أو الحرمة، والآخر غير الإلزامي، كالاستحباب والكراهة، فيؤخذ بما دلّ على الإلزامي، لعدم المزاحمة بين ما فيه الاقتضاء وما ليس فيه الاقتضاء.
نعم، إن قيل بأنّ دليل غير الإلزامي أيضاً يدلّ على أنّه كان عن العلّة والاقتضاء،
ص: 236
فيقع التزاحم بين المقتضيين، فالحكم هو الأخذ بما دلّ على غير الإلزامي، لعدم العلم بتمامية علّة الإلزامي والشكّ في وصول علّته بمرتبة تقتضي الإلزام.
أقول: يمكن أن يقال: إنّه على فرض شمول دليل الحجّية لما علم كذبه إجمالاً وكون مؤدّى کلّ منهما حكماً إلزامياً في موضوع واحد، يكون الحكم تساقطهما لا التزاحم والتخيير؛ فإنّ تزاحم الملاكين والمقتضيين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر يوجب عدم ثبوت الحكمين معاً، فالحكم في ذلك ما يقتضيه الأصل لا التخيير لأجل التزاحم، لأنّ التزاحم إنّما يقع بين الدليلين في ظرف تحقّق الملاك لكلّ واحد منهما وعجز المکلّف في مقام الامتثال عن الإتيان بكليهما. وهكذا إذا كان دليل غير الإلزامي أيضاً دالّا على كونه عن علّة واقتضاء، فإنّ لازم ذلك عدم الحكم بأحدهما لتعارض المقتضيين.
وبعبارة اُخرى: الصحيح أن يقال: إذا كان مؤدّى أحدهما الحكم الإلزامي والآخر الحكم غير الاقتضائي يؤخذ بالإلزامي، لعدم تعارض بينهما. وأمّا إذا كان مؤدّى الآخر الحكم الاقتضائي غير الإلزامي، كالكراهة والاستحباب والإباحة، إذا كان عن علّة مقتضية لها، فيقع التزاحم بينهما على مبنى صاحب الكفاية،((1)) لتعارض مثل مقتضى الوجوب ومقتضى الكراهة في شيء واحد، فيتساقطان. وهذا بخلاف باب التزاحم، فإنّ فيه يقدّم الإلزامي على غيره.
وأيضاً فما أفاد من الأخذ بحكم غير الإلزامي الاقتضائي دون الإلزامي لعدم العلم بتمامية علّة الإلزامي.((2))
فيه أيضاً: أنّ الحكم غير الإلزامي مثل أصالة البراءة أو الإباحة يجري بعد تساقط الإلزامي وغير الإلزامي الاقتضائي بالتعارض، فتأمّل جيّداً.
ص: 237
مقتضى دلالة الدليل من الأخبار أو الإجماع على عدم سقوطهما عن الحجّية - مع قطع النظر عن الدليل الدالّ على تعيين أحدهما أو التخيير بينهما - هو تعيّن ما فيه رجحان على الآخر، والظنّ بكونه هو الحجّة الواقعية أو كون مؤدّاه هو الواقع، وذلك للقطع بكونه حجّة تخييراً أو تعييناً، فالمتيقّن حجّية الراجح، بخلاف غيره فإنّه محكوم بعدم الحجّية بالأصل.
وأمّا مع ملاحظة الأخبار العلاجية، فقد وقع الاختلاف بينهم على قولين:
أحدهما: التخيير مطلقاً وإن كان أحدهما راجحاً. وهو ما ذهب إليه بعض القدماء مثل شيخنا الكليني(قدس سره) صاحب الكافي الشريف في ظاهر كتابه، وصاحب الكفاية من المتأخّرين.
ثانيهما: التعيين والأخذ بالراجح.
ومنشأ الاختلاف اختلاف ظاهر الأخبار، فإن بعضها يدلّ على التخيير، وبعضها ظاهر في وجوب الأخذ بالراجح. فمن قال بالتخيير حمل ما يدلّ على التعيين على الاستحباب. وبعبارة اُخرى: نظر إلى ما يدلّ على التخيير بأنّه ظاهر في تساوي عدليه ونصّ في جواز الاكتفاء بأيّهما شاء، وإلى ما يدلّ على التعيين وأنّه نصّ في رجحانه على الطرف الآخر وظاهر في تعيينه دون الآخر، فبنصّ هذا رفع اليد عن ظاهر الأوّل وبنصّ الأوّل رفع اليد عن ظاهر الثاني.
ولكن هذا بعيد عن ذهن العرف. ويمكن أن يكون المستند لمثل الشيخ الكليني(قدس سره) أمراً آخر لم يصل إلينا.
وأمّا وجه الذهاب إلى القول بالتعيين والأخذ بالراجح، فهو الجمع بين الطائفتين
ص: 238
بالإطلاق والتقييد، وتقييد إطلاق أخبار التخيير بما يدلّ على التعيين عند وجود الرجحان، فالنتيجة التخيير عند فقدان الراجح والتعيين في صورة وجوده، وهذا جمع عرفي.
وبعد ذلك کلّه، لابدّ من ذكر الأخبار الواردة في علاج المتعارضين والنظر فيهما، فنقول بحول الله تعالى وقوّته:((1)) من هذه الأخبار ما دلّ على التخيير على الإطلاق كخبر الحسن بن جهم عن الرضا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): قلت للرضا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): تجيئنا عنكم الأحاديث مختلفة؟
قال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «ما جاءك عنّا فقسه على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يشبههما فليس منّا».
قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحقّ؟
فقال(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «إذا لم تعلم فموسع عليك بأيّهما أخذت».((2))
وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة، فموسّع عليك حتى ترى القائم فتردّه عليه».((3))
ومكاتبة عبد الله بن محمّد الّتي رواها الشيخ عن أحمد بن محمّد((4)) عن العبّاس بن
ص: 239
معروف((1)) عن عليّ بن مهزيار((2)) قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد((3)) إلى أبي الحسن(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: أن صلّهما في المحمل، وروى بعضهم: أن لا تصلّهما إلّا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «موسّع عليك بأيّةٍ عملت».((4))
ومكاتبة محمّد بن عبد الله الحميري((5)) إلى مولانا الحجّة(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في مسألة القيام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة: هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب التكبير ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد؟
الجواب: «إنّ فيه حديثين: أمّا أحدهما، فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اُخرى فعليه التكبير. وأمّا الآخر، فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك في التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى. وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً».((6))
أقول: قد يقال بضعف سند خبر الحسن بن جهم بالإرسال، ولكن لا كلام في دلالته.
وخبر الحارث بن المغيرة أيضاً ضعيف السند بالإرسال. وقيل في دلالته: إنّه يدلّ على حجّية أخبار الثقة إلى ظهور الحجّة(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، ولا دلالة له على حكم المتعارضين.
ولكن الظاهر من الخبر كونه ناظراً إلى صورة تعارض الحديثين. لأنّ حجّية خبر الثقة
ص: 240
ليست مغيّاة برؤية القائم(عجل الله تعالی فرجه شریف). نعم، يمكن أن يقال: إنّ القدر المتيقّن منه صورة تكافؤ الحديثين ودوران الأمر بين المحذورين وعدم إمكان الاحتياط.
وبعبارة اُخرى: يكون موسّعاً عليه إذا صار تعارض الحديثين سبباً لوقوعه في الضيق والتحيّر، لا مطلقاً.
وأمّا المكاتبة الاُولى، فالظاهر منها أنّ الحكم في ركعتي الفجر التخيير الواقعي. وعلى فرض التعارض - لأنّ أحدهما روى لا تصلّهما إلّا على الأرض - يمكن أن يكون جواب الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) على أساس التخيير الواقعي في خصوص المورد. وعلى القول بالتعدّي عنه غايته التعدّي إلى سائر النوافل لا الواجبات وغيرها.
وأمّا المكاتبة الثانية، فقد قيل فيها: إنّ موردها خارج عمّا هو محلّ الكلام، لأنّ التعارض بين الخبرين يكون بالعموم والخصوص، فأحدهما يدلّ على استحباب التكبير إذا انتقل من حالة إلى حالة اُخرى، والآخر يدلّ على عدم استحباب التكبير إذا قام للركعة التالية، ومقتضى الجمع العرفي هو تخصيص العامّ بالخاصّ. وحكم الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بأنّ الأخذ بأيّهما من جهة التسليم يكون صواباً، لأنّ الأمر في المستحب سهل، فإن لم يكن التكبير مستحبّاً لانتقاله من حالة إلى حالة اُخرى فإنّه مستحبّ لأنّه ذكر في نفسه.
ومنها: ما دلّ على التوقّف مطلقاً.((1))
ومنها: ما دلّ على ما هو الحائط منهما.((2))
أقول: إن اُريد - ممّا يدلّ عليهما - الأخبار العامّة الدالّة على التوقّف والاحتياط في الشبهات؛ فهي مخصّصة بما يدلّ على خلاف ذلك. وإلّا فالظاهر أنّه لا يوجد ما يدلّ عليهما في الخبرين المتعارضين.
ص: 241
فالعمدة من أخبار الباب ما يدلّ على الترجيح بالمزايا والمرجحات المذكورة فيها. وأجمع خبر دلّ على المرجّحات خبران: (مرفوعة زرارة، ومقبولة عمر بن حنظلة).
أمّا الاُولى: فقد رواها ابن أبي جمهور((1)) عن العلّامة قدّست نفسه مرفوعاً إلى زرارة.
وضعفها من حيث السند غنيّ عن البيان. مضافاً إلى تصريح البعض بأنّه لم يجدها في ما بأيدينا من كتب العلّامة. ومع ذلك نجري الكلام في ما يستفاد من ألفاظها، فنقول:
أمّا الفقرة الاُولى، فإن كان المراد من قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «خذ بما اشتهر بين أصحابك» ما رواه الجميع، أو جمع يوجب إخبارهم القطع بالصدور، كالمتواتر قبال خبر الواحد، فمثله خارج عن باب الترجيح بالمزية، لأنّ المتواتر قطعي الصدور ولا يعارضه الشاذّ المظنون صدوره، وما يرجّح بالمزيّة لا يخرج بها عمّا هو ظنّي الصدور، فلا يوافق قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «خذ بقول أعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك» إذا كان أحدهما المشتهر بين الأصحاب يقينيّ الصدور.
نعم، إذا كان المراد من المشتهر ما يكون رواته عن الراوي عن المعصوم(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) أكثر وأشهر قبال الآخر الّذي رواته عمّن يروي عن المعصوم(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) أقلّ فلم يروه مثلاً عن محمّد بن مسلم إلّا نفر واحد يترتّب عليه الترجيح بالمرجّحات فيرجّح المشتهر على غيره.
وبعبارة اُخرى: الظاهر أن المراد من السؤال عن حديثين متعارضين ما إذا كان ينتهي رواة أحدهما إلى زيد ورواة الآخر إلى عمرو، والمشتهر بين الأصحاب ما كان منهما رواته عن الراوي الآخر أكثر، وعليه تستقيم الأسئلة والأجوبة التالية. بخلاف ما إذا كان المراد من المشتهر ما رواه الجميع أو كان ثابتاً بالتواتر، فإنّه لا يستقيم المعنى ولا يترتّب ما ذكره بعده من الأسئلة عليها، لأنّها ظاهرة في كون السؤال عن أخبار الآحاد. وبعد ذلك يمكن أن يقال: إنّ الترتيب المذكور في الحديث خلاف الاعتبار، لأنّه إذا كان الخبران
ص: 242
المتعارضان کلّ واحد منهما مشهوراً مروّياً واجداً کلّ منهما لشرائط الاعتماد عليه فمقتضى الاعتبار العرفي الرجوع إلى جهة صدورهما، فما لا يمكن حمله إلّا على بيان حكم الله الواقعي هو الحجّة وهو المخالف للعامّة يقدّم على ما يمكن أن تكون جهة صدوره الموافقة معهم تقية. وعلى هذا، كأنّه لا يوافق الحديث الاعتبار، فإنّه إذا أمكن رفع التعارض بملاحظة جهة الصدور لا تصل النوبة إلى الأخذ بقول الأعدل ولا وجه لجعل هذه الجهة متأخّرة عن التقديم بالأعدلية. هذا مضافاً إلى ما وقع في ذيل الحديث من الخروج عمّا هو ظاهره في صدره، فإنّ الظاهر من الصدر تعارض الخبرين على نحو وقع المكلّف بين المحذورين كوجوب فعل وحرمته والسؤالات المترتّبة على السؤال الأوّل وأجوبتها تنطبق على ذلك ولا ينطبق عليه الأخذ بالحائطة للدين إذا دار الأمر بين وجوب فعل أو حرمته. نعم، ينطبق عليه الحكم بالتخيير. وكيف كان لا اعتبار بهذا الخبر بعد ما عرفت من ضعف سنده واضطراب متنه. والله هو العالم.
وأمّا الثانية: وهي المعروفة ب- «مقبولة» عمر بن حنظلة، فقد رواها المشايخ الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم. وسندها على ما في التهذيب((1)) هكذا: محمّد بن عليّ بن محبوب،((2)) عن محمّد بن عيسى،((3)) عن صفوان،((4)) عن داود بن الحصين((5)) عن عمر بن حنظلة((6))...
ص: 243
وقد استشكل في الكفاية على الاستدلال بها لوجوب الترجيح بالمرجّحات المذكورة فيها:
أوّلاً: بقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة وفصل الخصومة الّذي لابدّ منه، فلا مجال لدعوى شموله غير مورد الحكومة لا بالإطلاق لتوقّفه على انتفاء القدر المتيقّن المفقود في المقام، ولا بتنقيح المناط، لأنّه لا يمكن دعواه بالقطع.
وثانياً: أنّ الرواية على فرض دلالتها على وجوب الترجيح بالمرجّحات مختصّة بزمان حضور الإمام وإمكان التشرّف بلقائه(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، فإنّ في آخره قال: «إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك» فلا تشمل زماننا الّذي لا يمكن لأحد الفوز بمثل هذا اللقاء.
وثالثاً: أنّ إطلاقات التخيير أظهر من المقبولة في وجوب الأخذ بالمرجّحات، لأنّ القول بوجوب الأخذ بها مستلزم لأن لا يبقى تحت إطلاقات التخيير إلّا الفرد النادر، فإنّه قلّ مورد يكون فاقداً لبعضها. والمناط کلّ المناط في تقديم المقيّد على المطلق كونه أظهر في الدلالة على معناه من المطلق وصيرورة المطلق محمولاً على الفرد النادر بالتقييد مانع من أظهريته في الدلالة على تقييد المطلق من ظهور المطلق في الإطلاق، فلابدّ إمّا من القول بورود المقبولة في خصوص الحكومة، أو حملها على الاستحباب.((1))
ورابعاً: يدلّ على أظهرية أخبار التخيير الاختلاف الواقع الكثير بين أخبار الترجيح.
وخامساً: بأنّ أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم ليست من أخبار باب علاج التعارض بالمرجّحات، لأنّ المستفاد منهما عدم حجّية المخالف للكتاب والموافق للقوم منهما، فمثل ما ورد في أنّ المخالف للكتاب زخرف أو باطل أو يضرب على الجدار، معناه عدم الحجّية رأساً، وكذا الخبر الموافق للقوم يصير موهوناً به مع معارضة المخالف لهم له ويسقط به الأصل المثبت صدوره لأجل بيان الحكم الواقعي فيسقط
ص: 244
عن الاعتبار ويخرج من باب التعارض. وعلى فرض أن نقول: إنّ أخبار موافقة الكتاب ومخالفة القوم تفيد ترجيح إحدى الحجّتين على الاُخرى نمنع أظهريّتها بالإطلاق على ظهور أخبار التخيير فيه، فلابدّ من حملها على الاستحباب إن لم نقل بكونها في مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة.
وسادساً: يلزم من عدم التوفيق بين أخبار موافقة الكتاب ومخالفة القوم وأخبار التخيير - بحمل الاُولى على تعيين الحجّة عن اللاحجّة، أو الاستحباب - تقييد الطائفة الاُولى بعضها ببعض مع إبائها عنه.
بيان ذلك: أنّه إذا كان الخبر الموافق للكتاب مخالفاً للقوم أو المخالف للكتاب موافقاً للقوم، فطريق الترجيح معلوم. وأمّا إذا كان الخبر الموافق للكتاب موافقاً لهم والمخالف للكتاب مخالفاً لهم، فيقع التعارض بين ما يدلّ على الأخذ بموافق الكتاب وما يدلّ على الأخذ بما هو مخالف للعامّة، وما يدلّ على ترك المخالف للكتاب وترك الموافق للعامّة، فلابدّ من القول بتقييد ما دلّ على الأخذ بالموافق للكتاب بما إذا لم يكن مخالفاً للعامّة مع أنّ هذه الأخبار مثل: «ما خالف قول ربّنا لم أقله، أو زخرف، أو باطل» تكون آبية عن التقييد.
وسابعاً: لو لم تحمل أخبار الترجيح على الاستحباب يلزم منه في أخبار التخيير ارتكاب ترك الاستفصال من الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) والسكوت في مقام البيان.
وبالجملة: يظهر من جميع ما ذكر أنّ إطلاقات التخيير محكمة ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها.((1))
أقول: يمكن الجواب أمّا عن الإشكال الأوّل، بأنّ المقبولة ناظرة إلى تعارض
ص: 245
الروايتين اللتين استند بهما الحَكَمين بما أنّهما روايتان متعارضتان، ولا نظر فيها إلى تعارض الحكمين، كما إذا كان حكمهما باجتهادهما في الروايات وتطبيقهما على المورد، ففي مثل ذلك يحكم مثلاً بأنّ الحكم ما حكم به أعلمهما. ولكن في المقام كأنّه لا خلاف بينهما في الموضوع وأنّ کلّا من الروايتين تنطبق عليه، إلّا أنّه لا يمكن الجمع بينهما، فكأن کلّ واحد منهما سأل عن حكم الموضوع حسب الرواية عمّن اختاره فأخبر کلّ منهما صاحبه برواية تتعارض رواية الآخر، فأعطى الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) القاعدة لرفع التعارض الروايتين، لا خصوص الحَكَمين، أو الحكمين لأن کلّ واحد منهما لم يجعل صاحبه حَكَماً ولم يسأله عن حكمه في الواقعة بل سأله عما هو عنده من روايات الأئمّة(علیهم السلام) فاختلفا في حديثهما عنهما، فقال الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث». ولم يسأل السائل عن حكم ما إذا اختلفا في أنّ أيّاً منهما بهذه الصفات، وسأل عن أنّهما عدلان مرضيّان فأجاب الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بما أجاب. ولم يسأله الراوي أيضاً عن صورة اختلافهما في الحكم المجمع عليه. وكذا لم يسأل عن صورة الاختلاف في الموارد الآتية، فكأنّه سأل عن حكم نفسه في صورة اختلاف الرواة. فظهورها في رفع التعارض بين الروايات أظهر من ظهورها في مقام فصل الخصومات وإن كان للقاضي أن يعمل بها كما أنّ للمفتي العمل بها. والله هو العالم.
وأمّا الإشكال الثاني، فيمكن الجواب عنه بأنّ انتهاء الأمر إلى لقاء الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) في عصر الحضور لا يوجب رفع اليد عن القواعد المذكورة قبل ذلك.
نعم، يأتي الكلام في أنّ في عصر الغيبة إذا انتهى الأمر إلى ما ذكر في الرواية كيف يكون العمل؟
ويمكن الجواب، بأنّه إن أمكن الاحتياط يحتاط، وإلّا فيعمل بما يقتضيه الأصل، وإن لم يمكن فهو بالخيار.
ص: 246
وأمّا الإشكال الثالث، فهو يرد لو قلنا بالتجاوز عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها. وأمّا إن لم نقل به واقتصرنا بالمنصوصة منها يكون ما يبقى تحت إطلاقات التخيير أكثر مما يخرج منها بالتقييد.
وأمّا الإشكال الرابع، فيمكن أن يقال: إنّ بعد رفع اليد عن المرفوعة والبناء على عدم حجّيتها - كما هي كذلك - يخرج الاختلاف بين أخبار العلاج عن الكثرة.
ويمكن الجمع بينها بتقديم ما يرجع به السند على ما فيه الترجيح لجهة الصدور.
وعلى فرض تعارضها وعدم تقديم بعضها على البعض - لما ذكر - يقال بالتخيير في مورد تعارض المرجّحات لا مطلقاً، فيؤخذ بذي المزيّة إذا لم يكن المعارض له كذلك.
وأمّا الجواب عن الإشكال الخامس، فيرد بأنّ ما هو خارج من الأخبار العلاجية ما يخالف الكتاب بالتباين دون ما كان مخالفاً لعمومه أو لإطلاقه؛ فإنّه لا ريب في صحّة تخصيص عموم الكتاب وكذا تقييد إطلاقه بالسنّة، فإذا كان أحد المتعارضين موافقاً لعموم الكتاب والآخر مخصّصاً له يقدّم ما يوافق العموم على المخالف له.
وأمّا ما يدلّ على الترجيح بمخالفة العامّة فلا وجه لخروجه عن أخبار العلاج، فإنّ مجرّد كون الخبر مخالفاً للعامّة لا يجعله موثوق الصدور ولا صادراً لبيان الواقع، كما أنّ مجرّد كونه موافقاً لهم لا يجعله غير موثوق الصدور ولا صادراً لعدم بيان الواقع.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إذا كان أحد الخبرين مخالفاً للعامّة لا يحتمل صدوره للتقيّة دون الّذي هو موافق لهم، فإذا كان سند کلّ منهما قطعياً يكون ترجيح المخالف لهم من تقديم الحجّة على اللاحجّة. نعم، إذا كان سند کلّ منهما ظنّياً يكون الترجيح للأخبار العلاجية، فتدبّر.
وأمّا الجواب عن الإشكال السادس، فيعلم ممّا ذكرنا في الجواب عن الخامس، فانه لا یمکن تقیید ما دل ترک المخالف للکتاب بما اذا لم یکن مخالفا للعامه اذا کان مردانا من المخالف ما خالف الکتاب بالتباین لا ما خالفه بالعموم او الخصوص.
ص: 247
وأمّا الإشكال السابع، فشبهة ترك الاستفصال والسكوت في مقام البيان قويّة. واحتمال أن يكون ذلك لمصلحة في مثل المورد بعيد جدّاً.
اللّهمّ إلّا أن يقال بعدم وجود دليل معتبر على التخيير لا يخلو من المناقشة في سنده.
وفي قبال ذلك استبعاد حمل المقبولة على الاستحباب أيضاً قريب جدّاً، لأنّ احتمال كون ذي المزيّة أقوى وأقرب من غيره يقتضي الحكم بتعيّنه ووجوب العمل به، ولا وجه للاستحباب في المقام.
فيتلخّص من ذلك کلّه أنّ الأقوى هو الأخذ بالمرجّحات المنصوصة مهما أمكن، وإلّا فهو بالخيار. والله هو العالم.
ص: 248
ذكر في الكفاية((1)) أنّه استدلّ على تقييد أخبار التخيير، ووجوب الترجيح بوجوه اُخر:
منها: دعوى الإجماع((2)) على الأخذ بأقوى الدليلين.
وفيه: أنّ دعوى الإجماع - مع مصير مثل الكليني إلى التخيير، وهو في عهد الغيبة الصغرى، ويخالط النوّاب والسفراء، قال في ديباجة الكافي: «ولا نجد شيئاً أوسع ولا أحوط من التخيير» - مجازفة.
أقول: لا صراحة بل ولا دلالة لكلام عروة الإسلام الكليني على الحكم بالتخيير مطلقاً ولو مع وجود المرجّحات الّتي صرّح هو بها في صدر کلامه. وكيف يحكم بذلك بعد التصريح بأمر الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بعرض الحديث على كتاب الله والأمر بترك ما وافق القوم والأخذ بالمجمع عليه؟! هذا مضافاً إلى أنّ الشيخ قد اختار تبعاً للمشهور الأخذ بالمرجّحات واستدلّ عليه بالإجماع المحقّق والسيرة القطعية.
ومنها: أنّه لو لم يجب الأخذ بالمرجّح وترجيح ذي المزيّة على غيره، يلزم ترجيح المرجوح على الراجح القبيح عقلاً، بل ممتنع قطعاً.((3))
ص: 249
واُجيب عنه: بأنّه إن كان مراد المستدلّ لزوم ترجيح المرجوح على الراجح في جعل الشارع، فيرد عليه أنّه يلزم ذلك إن كانت المزية موجبة لتأكّد ملاك الحجّية عنده بأن كان خبر الأعدل أغلب إيصالاً إلى الواقع من خبر العادل؛ وهو ممنوع، لاحتمال كون المزيّة المحتملة كونها موجبة للترجيح غير موجبة له. هذا مضافاً إلى أنّ الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع في غير محلّه، فإنّ الترجيح بلا مرجّح في الأفعال الاختيارية الّتي منها الأحكام الشرعية يكون قبيحاً، ولا يستحيل وقوعه إلّا من الحكيم تعالى، وإلّا فهو بمكان من الإمكان لكفاية كون إرادة المختار علّة لفعله، وما هو الممتنع وجود الممكن بلا علّة، فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح إلّا من باب امتناع صدوره منه تعالى، وأمّا غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح ممّا هو باختياره.
وبالجملة: الترجيح بلا مرجّح بمعنى بلا علّة محال، وبمعنى بلا داعٍ عقلائي قبيح ليس بمحال، فلا تشتبه.
أقول: يمكن أن يقال: إنّ المسألة ليست من التعبّديات الصرفة الّتي لا طريق لنا إلى درك وجهها وحكمتها، وليس الملاك في باب حجّية الخبر غير كونه طريقاً إلى الواقع، ولا ريب أنّ المرجّحات المذكورة توجب أقوائية ذي المزيّة على غيره وكونه أرجح من الآخر عند العرف، فلا يصحّ للمولى أن يأمر بالأخذ بغيره، أو يخيّر عبده بالأخذ بأيّهما شاء إذا لم يكن هنا وجهٌ للتخيير ولو كان هو التسهيل على العبد.
وبالجملة: ليس في المقام أمرٌ لزم ملاحظته إلّا الإيصال إلى الواقع، ولا ريب في أنّ احتمال الوصول إليه بالأخذ بذي المزيّة أقوى من غيره ويجب الأخذ به ولا يجوز الحكم بالتخيير معه. والله هو العالم.
ص: 250
ثم إنّه على القول بالتخيير يجري الكلام في مقامات:
الأوّل: لا إشكال في تخيير المجتهد في الأخذ بواحد من المتعارضين، وهذا هو التخيير في المسألة الاُصولية.
الثاني: لا يجوز له الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية إذا كان مضمون الخبرين دائراً بين المحذورين كوجوب شيء وحرمته، وذلك لأنّ مفاد دليل التخيير التخيير في الأخذ بأحدهما وجعله حجّة للعمل بمضمونه، لا التخيير بين الفعل والترك. والإفتاء بالتخيير بينهما إفتاء بغير ما أنزل الله ومخالف لما يستفاد منهما، وهو نفي الحكم الثالث مثل التخيير.
الثالث: لا يجوز في مقام القضاء وفصل الخصومة الإفتاء بالتخيير في المسألة الاُصولية. وبعبارة اُخرى: لا يجوز للحاكم الحكم في المسألة الاُصولية، لأنّه لا يفصل به الخصومة، فعليه أن يختار أحدهما ويفصل الخصومة بالحكم على طبق ما اختاره.
وأمّا في غير مقام القضاء ففي المسألة وجوه:
الأوّل: أنّه ليس له الإفتاء في المسألة الاُصولية بالتخيير، ويتعيّن عليه اختيار أحدهما والإفتاء بمدلوله للمقلّد.
الثاني: وجوب الإفتاء عليه بالتخيير في المسألة الاُصولية للمقلّد. وعليه إن کان المجتهد والمقلد مشترکین فی المساله ان یختار غیرز ما اختاره مقلده المجتهد.
ص: 251
الثالث: أن يكون المجتهد بالخيار في الإفتاء للمقلّد في المسألة الاُصولية، كما يجوز له الإفتاء في المسألة الفرعية.
وجه الأوّل: أنّ إفتاء المجتهد المقلّد بالتخيير في المسألة الاُصولية إفتاء بغير ما هو وظيفة المقلّد، فإنّ عليه التقليد في المسائل الفرعية، وأمّا الاُصولية فهي شأن المجتهد العارف بها.
ويمكن الجواب عن ذلك: بأنّه لِمَ لا يكون للمقلّد بعد انتهاء المجتهد إلى التخيير في العمل بأيّ منهما شاء هذا الاختيار؟ وما الفرق بينهما في ذلك؟ وبالجملة: التخيير وظيفة المتحيّر المواجه للمتعارضين، ولا فرق فيه بين المجتهد والمقلّد.
ووجه القول الثاني: أنّ حجّية فتوى المجتهد للمقلّد موردها عجز المقلّد عن تعيين وظيفته واضطراره إلى المجتهد فيه، وفي المقام هو ومقلَّده المجتهد في اختيار أحد الخبرين سواء.
وفيه: أنّ القدر المتيقّن من أخبار التخيير هو تخيير المکلّف العارف بتعارض المتعارضين دون من لا يعرف من ذلك شيئاً. نعم، يمكن أن يقال بالتخيير أي في المسألة الفرعية إذا كان المقلّد متجزّياً عارفاً بالتعارض.
ووجه القول الثالث: أنّه يجوز له أن يخيّر المقلّد بالتخيير في المسألة الاُصولية، ويجوز له أن يخيّره بما اختاره منهما أنّه الحكم الشرعي.
وفيه: أنّ كون ما اختاره الحكم الشرعي للمقلّد أوّل الكلام.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ جواز إفتائه بما اختاره في عمل نفسه وعمل مقلّده مما لا کلام فيه، وإنّما الكلام في جواز إفتائه له في المسألة الاُصولية.
ثم اعلم: أنّه على القول بالتخيير لابدّ من القول بكونه ابتدائياً، فإنّه مع قطع النظر
ص: 252
عمّا قيل في وجه كونه استمرارياً وما اُجيب عنه،((1)) يكون القول بكونه استمرارياً موجباً في الظاهر اللعب بأمر الشرع وتوهينه عند العرف، فإنّه على القول به يجوز للمجتهد وللمقلّد فيما إذا دلّ أحدهما على وجوب فعل والآخر على حرمته، واتّفق مورده في وقائع متعدّدة وأزمنة متعاقبة، اختيار ما دلّ على الوجوب في واقعة، وما دلّ على الحرمة في واقعة اُخرى، واختيار هذا في الزمان الأوّل، والآخر في الزمان الثاني، ويجوز للقاضي اختيار مفاده و الحكم على أحد الخصمين، واختيار غيره في الحكم على الآخر في قضيّتين متماثلتين، فمناسبة الحكم والموضوع واستظهار الحكم من الحكم بالتخيير تقتضي التخيير الابتدائي في المسألة الاُصولية مرّة واحدة، والبناء على أحد المتعارضين في جميع القضايا والمصاديق. والله هو العالم.
ص: 253
ص: 254
وأمّا الكلام في التعدّى عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها، فيمكن أن يقال: يستفاد ممّا يدلّ على التخيير، أو على التوقّف إلى الفوز بلقاء الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، بعد التنصيص على المرجّحات المنصوصة، عدم اعتبار غيرها فهو على التخيير بعد فقد المرجّحات المذكورة في النصوص، وإن كان الأحوط الأخذ بغير المنصوصة أيضاً((1)) إذا كان موجباً لرجحان احتمال إصابة ذيه إلى الواقع.
لا يقال:((2)) إنّ جعل شيء فيه خصوصية الطريقية وإراءة الواقع مرجّحاً، لا يدلّ على أنّ ذلك تمام الملاك في جعله حجّة.
فإنّه يقال: يستفاد ذلك منه بمناسبة الحكم والموضوع، فإنّ الحكم في أمثال هذه الاُمور ليس بالتعبّد، وإنّما الغرض فيه رعاية الواقع.
واستدلّ أيضاً على لزوم التعدّي بالتعليل في الروايات ب- «أنّ المشهور ممّا لا ريب فيه» باستظهار أنّ العلّة هو: عدم الريب بالإضافة إلى الآخر.
واُجيب عنه بأنّ الرواية المشهورة بين الرواة والأصحاب هي ما لا ريب فيها أصلاً بحيث تطمئنّ النفس بصدورها، لا ما لا ريب فيها بالإضافة إلى غيرها، فغاية الأمر نقول بالتعدّي إلى کلّ مزيّة توجب هذا الاطمئنان.
ص: 255
كما استدلّ عليه أيضاً بالتعليل على «أنّ الرشد في خلافهم». وتقريب الاستدلال به: أنّ المراد منه ليس من جهة كون الحقّ في خلافهم دائماً، لبطلانه بالوجدان، بل الظاهر منه كون الحقّ في مخالفتهم غالباً، لكون المخالف لهم أقرب إلى الواقع غالباً، فما يكون أقرب إلى الواقع يتعيّن الأخذ به ولو لم يكن منشأه مخالفة القوم.
والجواب عنه: أنّ من المحتمل كون الرشد في نفس المخالفة لحسنها، لا مطلقاً، بل إذا تعارض المخالف لهم ما يوافقهم سلّمنا أنّه لغلبة الحقّ في طرف الخبر المخالف، لكن ذلك يوجب الوثوق بالخلل في الموافق لهم صدوراً أو جهة، وفي ما يوجب هذا الوثوق لا بأس بالتعدّي؛ وفيه منع حصول هذا الاطمئنان.
ثم إنّه ربما يقال: بأنّه لا يعتبر في التعدّي إلى المزايا غير المنصوصة إلى خصوص ما يوجب الظنّ أو الأقربية بل يتعدّى إلى کلّ مزية وإن لم توجب أحدهما؛ وذلك لأنّ في المزايا المنصوصة ما لا يوجب واحداً منهما مثل أورعية الراوي وأفقهيته فإنّ التورّع والجهد في العبادة وكثرة التتبّع في الفقه لا يوجب الظنّ بكون ما أخبر به الواقع وأقربيته، قبال ما أخبر به الورع والفقيه.
لا يقال: إنّ ما يوجب الظنّ بصدق أحد الخبرين لا يكون مرجّحاً، بل موجباً لسقوط الآخر عن الحجّية للظنّ بكذبه حينئذ.
فإنّه يقال: الظنّ بالكذب لا يضرّ بحجّية الخبر المجعول حجّة من باب الظنّ النوعي. هذا مضافاً إلى أنّ حصول الظنّ بكذب الآخر مختصّ بصورة العلم بكذب أحدهما، وإلّا فلا يوجب الظنّ بصدوره الظنّ بعدم صدور الآخر، لإمكان صدوره مع عدم إرادة ما هو الظاهر منهما أو أحدهما، أو لأجل التقيّة.
هذا کلّه بناءً على كون وجه التعدّي والاستظهار من الروايات إلغاء الخصوصية ومجرّد كون أحدهما ذا المزيّة بالنسبة إلى الآخر وإن لم يكن موجباً للظنّ أو الأقربية.
ص: 256
أمّا إذا كان وجه التعدّي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين يجب الاقتصار على المزية الّتي توجب قوّة ذي المزيّة في الدليلية والطريقية، فلا يرجّح أحدهما على الآخر لما يوجب قوّة مضمونه ثبوتاً، كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنّية، فإنّ المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقّن منها إنّما هو الأقوى دليلية وطريقية.
وفي ما ذكر منع وجود ما لا يوجب الظنّ بالأقربية في المرجّحات المنصوصة، فإنّ ورع الراوي وفقهه وهكذا أورعيته وأفقهيته يكون موجباً للظنّ بكون خبره أقرب إلى الواقع، فلا يجوز التعدّي إلى مطلق المزيّة إذا كانت وجودها كالعدم بالنسبة إلى الإصابة إلى الواقع. والله هو الموفّق للصواب.
ص: 257
ص: 258
هل الأخبار الدالّة على التخيير أو الترجيح تشمل ما إذا أمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين بحمل الظاهر على الأظهر، كالعامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّد، أو تختصّ بغير موارد التوفيق العرفي؟ فإنّ العبد إذا قال له مولاه: اشتر کلّ ما في السوق من الفواكه، وقال: لا تشتر التفاح، لا يتحيّر في تكليفه ويعلم أنّه مكلّف بشراء غير التفّاح ممّا في السوق من الفواكه، ولا يرجع إلى مولاه في ذلك، وحكمه بالتخيير بين العمل بالعامّ أو الخاصّ أو ترجيح دليل أحدهما على الآخر، كأنّه مناقض لمدلولهما العرفي وما بينهما من التوفيق. فلا تحیّر حتّى يحتاج إلى رفعه، وإن قيل به في ابتداء الأمر لمن لا يتفطّن باُسلوب الاستفادة من الكلام والخطاب، فإنّه يزول بمجرّد التفطّن.
وممّا يدلّ على ذلك - أي على أنّ العرف لم يكن متحيّراً في التوفيق بين مثل العامّ والخاصّ - ما في نهج البلاغة من «أنّ في كتاب الله الخاصّ والعامّ».((1))
وبالجملة: قد جرت سيرة العرف وسيرة أهل الشرع والمتشرّعة على ذلك، فلا يقبل التخيير والأخذ بالعامّ وترك الخاصّ أو ترجيحه على الخاصّ، بعد حكم العرف وأهل المحاورة فيهما بحمل الظاهر على الأظهر والعامّ على الخاصّ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في المقام.
ص: 259
ص: 260
لا إشكال في أنّ عند تعارض الظاهر والأظهر يحمل الأوّل على الثاني فيما إذا ظهر ذلك. وأمّا إذا اشتبه الحال ولم يتيسّر التمييز، فهما ملحقان بما لا يمكن التوفيق بينهما، فلا يجوز ترجيح أحدهما على الآخر. ومع ذلك قد ذكروا لتقديم أحدهما على الآخر وجوهاً، نشير إلى بعضها وما قيل فيها:
منها: تقديم العامّ على المطلق،((1)) والتقييد على التخصيص، فيما إذا كان أحد الدليلين عامّاً والآخر مطلقاً؛ وذلك لأنّ ظهور العامّ في العموم تنجيزي ومستند إلى الوضع، وظهور المطلق في الإطلاق تعليقي، فإنّه معلّق على مقدّمات الحكمة، الّتي منها عدم بيان ما يصلح أن يكون مقيّداً له، والعامّ صالح لأن يكون بياناً، فإذا قال المولى: «لا تكرم الفاسق»، وقال بعده أو قبله: «أكرم العلماء»، فدلالة العامّ على شموله لجميع أفراده تنجيزي لا تحتاج إلى أمر زائد على العامّ، بخلاف لا تكرم الفاسق، فإنّ دلالته وشموله لجميع أفراد الفاسق معلّق على عدم ما يصلح أن يكون بياناً له، والعامّ صالح لذلك، سواء كان صادراً قبل صدور المطلق أو بعده.
واُجيب عن ذلك:((2)) بأنّ عدم دلالة المطلق على الشمول والعموم موقوف على عدم ما يصلح أن يكون بياناً للقيد في مقام التخاطب لا إلى الأبد. فعلى هذا، يقدّم
ص: 261
العامّ على المطلق إذا كان صادراً بعد العامّ، أمّا إذا صدر العامّ بعد المطلق وانعقاد ظهوره في العموم والشمول لا يقدّم العامّ عليه، ولا يكون ظهوره أظهر من ظهوره.
ويمكن أن يقال: نعم، انعقاد ظهور المطلق في العموم والشمول يحتاج إلى عدم البيان في مقام التخاطب، لكن بقاء ظهوره فيه يحتاج إلى عدم البيان إلى الأبد، فكلّ ما ورد بعد ذلك يكون وارداً عليه وبياناً له، فيكون المطلق قبل ذلك كالاُصول العمليّة بالنسبة إلى الأمارات، إذن يتّجه تقديم التقييد على التخصيص مطلقاً، سواء كان العامّ وارداً قبل المطلق أو بعده.
وبهذا البيان لا نحتاج إلى التمسّك بالدور بأن يقال: لو لم يقدّم تقييد المطلق على تخصيص العامّ يلزم تخصيص العامّ إمّا بلا مخصّص أو على وجه دائر؛ فإنّ تخصيص العامّ بالمطلق متوقّف على إطلاقه المتوقّف على عدم كون العامّ بياناً ومقيّداً له، وكون العامّ كذلك متوقّف على إطلاق المطلق.
وإن شئت قل: كون المطلق مخصّصاً للعامّ متوقّف على تحقّقه معه، وتحقّقه معه متوقّف على كونه مخصّصاً له.
ومنها: ترجيح التقييد لكونه أغلب من التخصيص.((1))
وردّ بمنع أغلبية التقييد مع كثرة التخصيص حتى قيل: ما من عامّ إلّا وقد خصّ.((2))
ويمكن أن يقال: بناءً على تفسير المشهور من المطلق ب- «الماهية المرسلة»((3)) کلّما يقيّد المطلق بشيء فهو مستعمل فيها بالتقييد، والعامّ وإن خصّص بغير ما خصّص به
ص: 262
مستعمل في العامّ، وإنّما الخاصّ يدلّ على عدم كونه محكوماً بحكم العامّ لا على خروجه من تحته، فلذلك يكون التقييد في المطلق أكثر بل مختصّ به دون العامّ.
وفيه: أنّ ذلك لا يوجب أولوية التقييد على التخصيص بهذا المعنى، فتأمّل.
منها: ما قيل بأنّه إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ يقدّم التخصيص على النسخ لغلبته وندرة النسخ.
أقول: إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص فورد مثلاً: «لا تكرم زيداً العالم» وبعد حضور وقت العمل به ورد «أكرم العلماء» فعلى القول بكون أصالة عدم النسخ كالاستصحاب من الاُصول العملية، فالوجه كون العامّ ناسخاً للخاصّ بأصالة العموم، وانتفاء المعارضة بين العامّ والخاصّ لتقدّم الدليل على الأصل. بل يمكن أن يقال: إنّ مثله ليس من النسخ الحقيقي، بل حكم ظاهريّ كسائر الأحكام الظاهرية والعامّ كاشف في مورده عن الواقع والحكم الواقعي، والنسخ إنّما يكون في الأحكام الواقعية. واحتمال كون الخاصّ مخصّصاً للعامّ مردود، لكونه موجباً لتقديم الأصل على الدليل، كما لا يخفى.
وعلى القول بكون أصالة عدم النسخ من الاُصول اللفظية مرجعها إلى أصالة العموم الجارية في الخاصّ، فالقول بتخصيص العامّ به مستلزم لتقديم ما هو المستفاد من الإطلاق على المستفاد من الوضع. وبعبارة اُخرى: إنّه تقديم العموم الأزماني - الثابت للخاصّ بالإطلاق - على العموم الأفرادي - الثابت للعامّ بالوضع - وهو خلاف التحقيق. ومقتضى ذلك: القول بالنسخ في طرف الخاصّ، وحينئذ يمكن أن يقال: بأنّ غلبة التخصيص على النسخ موجب لقوّة ظهور الخاصّ في العموم الأزماني وأظهريته فيه من ظهور العامّ في العموم الأفرادي. وبعبارة اُخرى: أظهرية التخصيص على التقييد.
ص: 263
ولكن يمكن أن نقول: إنّه ليس هنا نسخ وناسخ ومنسوخ، فإنّ ظهور الخاصّ في حرمة إكرام زيد في جميع الأزمنة يكون بالإطلاق المتوقّف على عدم البيان، والعامّ صالح لأن يكون بياناً، وعليه يكون الأخذ بالعامّ بدليله وأصالة العموم، وترك إطلاق الخاصّ لعدم انعقاد ظهوره فيه وعدم الدليل عليه. نعم، لا يجيء ذلك على مختار صاحب الكفاية، فإنّه عدّ من مقدّمات الحكمة((1)) عدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب، فتدبّر جيّداً.
ثم إنّه بناءً على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنّة بالأدلّة المخصّصة الواردة عن الأئمّة الطاهرين(علیهم السلام)؛ وذلك لأنّ دوران الأمر بين التخصيص والنسخ فيما إذا كان الخاصّ وارداً قبل حضور وقت العمل بالعامّ غير معقول، لأنّ النسخ حقيقته رفع الحكم الفعلي، وقبل حضور وقت العمل لا حكم فعليّ حتّى يرفع بالنسخ فليس هنا إلّا التخصيص.
وكذلك لا يعقل الدوران بينهما إذا كان الخاصّ وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، فإنّه لا يمكن أن يكون مخصّصاً للعامّ، لأنّه مشروط بكونه وارداً قبل حضور زمان العمل بالعامّ، وبعده لا يكون إلّا ناسخاً له.
وربما يجاب عن ذلك بالالتزام بالنسخ بناءً على جواز ورود النسخ عن الأئمّة(علیهم السلام)، بأن يقال: إنّ النبي(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، أنشأ الناسخ ولكن لم يخبر به غير الأئمّة(علیهم السلام)، ولم يأذن لهم أن يخبروا به الناس إلّا عند اقتضاء المصلحة أو عند رفع المانع من إظهاره والإخبار به.
وفيه: أنّ هذا بعيد جدّاً وخلاف إكمال الدين بتبليغ جميع أحكامه وشرائعه، مضافاً إلى أنّه ليس من النسخ الحقيقي.
ص: 264
وأيضاً ربما يجاب عن هذا الإشكال بأنّ من الممكن كون العامّ محفوفاً بقرائن يستفاد منها ما يستفاد من الخاصّ ولكن بمرور الزمان خفيت القرائن، والخاصّ إخبار عن الحكم الصادر عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ).
وهذا قريب جدّاً، لاسيّما وقد حدث بعد ارتحال النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) إلى الرفيق الأعلى من الأحداث السياسية وغصب حقّ أمير المؤمنين(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، ومنع الحكومة الرواية عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بناءً على أساسهم الفاسد بقولهم: حسبنا كتاب الله، حتى منعوا النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عن كتابة وصيته في مرض موته.((1))
فلا يقال: إنّ عموم البلوى بالأحكام يمنع من خفائه لكثرة الدواعي في نقلها وحفظها.
فإنّه يقال: نعم، ولكن قد وقع من الاُمّة ما لا يستبعد بوقوعه خفاء أكثر الأحكام حتى أنّ القوم أيضاً اعترفوا بتلك المصيبة العظمى، فقد جاء في صحيح البخاري أنّ أنس قال: ما أعرف شيئاً ممّا كان على عهد النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، قيل: الصلاة؟ قال: أليس ضيّعتم ما ضيّعتم فيها، وروي نحوه عن أبي الدرداء وغيرهما.((2))
ص: 265
ص: 266
لا يخفى أنّه إذا كان التعارض بين الإثنين وكان أحدهما أظهر من الآخر يحمل الظاهر على الأظهر، وإذا لم يكن أحدهما كذلك فالحكم ما ذكر من التخيير أو الترجيح.
وأمّا إذا وقع التعارض بين أزيد من اثنين كما إذا كان هنا عامّ قد خصّص بخاصّين أو أزيد فتارة: تكون نسبة أحدهما مع العامّ بعد ملاحظته مع الثالث كنسبته قبل هذه الملاحظة، كما إذا قال: «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق منهم» و«لا تكرم زيداً العالم العادل» فإنّ نسبة «لا تكرم زيداً العالم العادل» مع «أكرم العلماء» العموم المطلق، وبعد ملاحظة العامّ مع قوله: «لا تكرم الفسّاق منهم» يخصّص العامّ بالعلماء العدول، ونسبة «لا تكرم زيداً العالم العادل» معه العموم المطلق لا تتفاوت قبل ملاحظة نسبة العامّ مع «لا تكرم الفسّاق منهم» وبعده. وهكذا لا تتفاوت نسبة «لا تكرم الفسّاق منهم» مع العامّ بعد ملاحظة تخصيصه ب- «لا تكرم زيداً العالم العادل» وقبله. ففي مثله لا تنقلب النسبة بملاحظة نسبة أحد الخاصّين مع العامّ بعد ملاحظة نسبته مع الآخر، فلا محلّ للاختلاف في أنّه هل يلاحظ کلّ خاصّ مع العامّ بنفسه أو بعد ملاحظة نسبة الخاصّ الآخر معه وتخصيصه به؟
مثال آخر: إذا قال: «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق» و«يستحبّ إكرام الشعراء»، فنسبة کلّ واحد منها إلى الآخر بنفسه العموم من وجه، فمادّة افتراق العلماء من الفسّاق «العالم العادل» ومن الشعراء «العالم غير الشاعر» ومادة افتراق الفسّاق من
ص: 267
العلماء «الفاسق غير العالم» ومن الشعراء «الفاسق غير الشاعر»، وأيضاً مادّة افتراق الشعراء من العلماء «الشاعر غير العالم» ومن الفسّاق «الشاعر غير الفاسق». ومادّة اجتماع «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق» العالم الفاسق ومادّة اجتماع «أكرم العلماء» و«يستحبّ إكرام الشعراء» «العالم الشاعر»، ومادّة اجتماع «لا تكرم الفساق» و«يستحب إكرام الشعراء» «الشاعر الفاسق».
ثم إذا لوحظ، نسبة کلّ من الثلاثة مع غيره منها بعد ملاحظة الآخر معه تكون النسبة بينهما عموماً من وجه، فإذا خصّص العلماء بغير الفاسق تكون النسبة بينه وبين الشعراء عموماً من وجه، لا تنقلب النسبة التي كانت بين الشعراء والعلماء قبل تخصيص العلماء بغير الفاسق.
مثال آخر: «أكرم العلماء» و«يكره إكرام العصاة منهم» و«يحرم إكرام مرتكب الكبيرة منهم».
وبالجملة: فمثل هذه الأمثلة خارجة عن محلّ الكلام، وإنّما الكلام في صورة انقلاب النسبة بعد الجمع بين أحدها والآخر وحمل الظاهر منهما على الأظهر وملاحظة الثالث كما إذا ورد «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفسّاق منهم» و«يستحبّ إكرام الشعراء منهم» فنسبة أكرم العلماء، وإن شئت قلت: نسبة وجوب إكرام العلماء مع کلّ من حرمة إكرام الفسّاق منهم واستحباب إكرام الشعراء منهم، نسبة العامّ والخاصّ (العموم المطلق)، ولكن إذا خصّص وجوب إكرام العلماء بحرمة إكرام الفسّاق ثم لوحظ معه استحباب إكرام الشعراء منهم تنقلب النسبة الّتي كانت بينه وبين العامّ بالعموم من وجه.
وهكذا لو لوحظ أوّلاً نسبة استحباب إكرام الشعراء من العلماء مع وجوب إكرام العلماء، ثم لوحظت نسبة حرمة إكرام الفسّاق منهم معه، تنقلب النسبة من العموم
ص: 268
المطلق إلى العموم من وجه، فمادة افتراق وجوب إكرام العالم غير الفاسق مع استحباب إكرام الشعراء من العلماء وجوب إكرام العالم العادل غير الشاعر، ومادّة افتراق استحباب إكرام الشعراء عن وجوب إكرام العالم العادل استحباب إكرام العالم الشاعر الفاسق، ومادّة اجتماعهما العالم العادل الشاعر.
وفي هذا القسم من التعارض الواقع بين أكثر من إثنين وقع الخلاف في أنّ علاج التعارض هل يكون بملاحظة کلّ منهما بنفسه مع الآخر بنفسه؟ ففي المثال يخصّص عامّ «أكرم العلماء» ب- «لا تكرم الفسّاق منهم»، ويقال بتخصيص العامّ بالخاصّ، كما يخصّص باستحباب إكرام الشعراء منهم، ويقال بوجوب إكرام غير الشعراء من العلماء؟ أو أنّه يعالج تعارض أحدهما مع الآخر بملاحظة کلّ منهما بنفسه أوّلاً وحمل أحدهما على الآخر، وملاحظة نتيجة هذه الملاحظة ثانياً مع الثالث؟ فإنّه يكون بالعموم من وجه فيأتي الكلام في مادّة اجتماعهما، كما قلنا في المتباينين من القول بالتخيير أو الترجيح.
نسب الثاني إلى الفاضل النراقي((1)) إمّا مطلقاً أو إذا كان أحد الخاصّين لبّياً والآخر لفظياً.
ووجه الثاني: أنّ المخصّص إذا كان لبّياً يكون كالمخصّص المتّصل في مزاحمته لظهور العامّ فيه، ويكون العامّ المخصّص به ظاهراً في غير ما خصّص به، فيلاحظ هو مع العامّ ويخصّص العامّ به، ثمّ يلاحظ نسبة الثالث مع العامّ.
ويجاب عن ذلك بأنّه ليس من المتّصل بشيء، فإنّ في المخصّص المتّصل يستعمل العامّ في العموم، ويستفاد ضيق دائرته من مدخوله وتقيّده بقيد خاصّ، فلا ينعقد له الظهور سعةً وضيقاً إلّا بمدخوله. وأمّا في المخصّص اللبّي فينعقد له الظهور في
ص: 269
مدخوله اللفظي دون اللبّي، وإنّما يكون المخصّص اللبّي مانعاً عن حجّية العموم فيه لا عن ظهوره فيه.
ومن هنا يظهر الجواب إذا كان المراد من هذا القول، أي لحاظ العامّ مع أحد الخاصّين المنفصلين ثم لحاظ العامّ المخصّص به مع الآخر، أعمّ من المنفصل اللفظي واللبّي؛ وذلك لعدم انثلام عموم العامّ بورود المخصّص المنفصل عليه سواء كان لفظياً أو لبّياً، غاية الأمر أنّه مانع عن حجّيته فيه، فظهور العامّ باقٍ على حاله ونسبة الخاصّ الآخر معه باقية على حالها.
وبالجملة: العامّ المخصّص بالمنفصل مستعمل في العموم وظاهر في كونه مراداً بالإرادة الجدّية، والخاصّ يدلّ على عدم كونه مراداً كذلك فيه، لا أنّه ليس ظاهراً في العموم واستعمل في غير الخاصّ، فلا يرتفع به التعارض الّذي كان بينه وبين الخاصّ بالعموم المطلق.
ويدلّ على عدم انثلام عموم العامّ بورود التخصيص عليه حجّيته في تمام الباقي، وإلّا فيمكن أن لا يكون حجّة فيه لإمكان أن يكون المستعمل فيه العامّ دون هذه المرتبة ومرتبة من مراتبه. وأيضاً يأتي الكلام في وجه سبق تخصيص العامّ بأحد الخاصيّن دون الآخر. وفي غير العامّ والخاصّ أيضاً من الأدلّة المتعارضة يأتي هذا الإشكال؛ فإنّ تقديم هذا الخاصّ في تخصيص العامّ على الآخر أو ملاحظة نسبة هذا الدليل مع الآخر أوّلاً دون الثالث ترجيح بلا مرجّح.
وبهذا يجاب عمّا يقال: من أنّ التعارض بين الدليلين أو الأدلّة يلزم أن يكون واقعياً، ولا يكون ذلك إلّا فيما يكون الدليلان حجّة فيه. وبعبارة اُخرى: لا يتحقّق التعارض إلّا إذا كان کلّ من الدليلين أو الأدلّة حجّة فيما كان غيره حجّة فيه بعد تخصيصه بالدليل الآخر لا قبله، فإنّ دفع التعارض حينئذ بين الأدلّة، مثل العامّ
ص: 270
والخاصّين، إذا كان منوطاً بملاحظة مدلول أحدهما مع الآخر ثم ملاحظة مدلول الآخر مع نتيجة الملاحظة الاُولى الّذي هو معارض لها، يحتاج إلى تقديم تخصيص العامّ بأحدهما ثم ملاحظة مدلول الآخر مع مدلول العامّ المخصّص بالأوّل ولا ريب أنّ تقديم کلّ منهما على الآخر ترجيح بلا مرجّح.
وبعبارة اُخرى: إذا قلنا بعدم وقوع التعارض بين العامّ بنفسه إذا كان مخصّصاً والخاصّ الآخر، لأنّ العامّ بنفسه ليس حجّة في مدلوله بل حجّة في غير المخصّص من أفراده، فلابدّ أن يقال بوقوع التعارض بين العامّ حال كونه مخصّصاً بأحد الخاصّين والخاصّ الآخر؛ يقع الكلام في تقديم تخصيص العامّ بهذا الخاصّ أو بغيره، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر مع أنّ النتيجة تتفاوت به.
ففي المثال: إذا خصّصنا أوّلاً عموم «أكرم العلماء» ب- «لا تكرم الفسّاق منهم»، تكون النتيجة وجوب إكرام العلماء العدول، ونسبة استحباب إكرام الشعراء منهم معها العموم من وجه، ويقع التعارض بينهما في العالم الشاعر العادل. وأمّا إذا خصّصنا أوّلاً عموم «أكرم العلماء» باستحباب إكرام الشعراء منهم تكون النتيجة وجوب إكرام العلماء غير الشعراء منهم، والنسبة ما بين تلك النتيجة وحرمة إكرام الفسّاق منهم أيضاً العموم من وجه، فيقع التعارض بينهما في العالم الفاسق غير الشاعر. إذن فلا وجه لتقديم إحدى الملاحظتين على الاُخرى.
فإن قلت: يخصّص العامّ بكلّ من الخاصّين بعد تخصيصه بالآخر.
قلت: نتيجة ذلك تساقط الجميع في مداليلهما إذا قلنا بتساقط الدليلين في مادّة الاجتماع، فالعلماء کلّهم إمّا هم فسقة غير الشعراء، وإمّا هم شعراء عدول، ولا يبقى منهم إلّا العلماء الفسقة، والنتيجة تكون وجوب إكرام العلماء من الفسقة والتخصيص المستهجن، ولا أظنّ يلتزم به الفاضل النراقي ومن يرى رأيه.
ص: 271
وبالجملة: فالوجه هو مختار الشيخ((1)) وصاحب الكفاية.((2)) وحينئذ إذا كان هناك عام مخصّص بخاصّين أو أكثر، فإمّا أن يكون على نحو لو خصّص بالخاصّين لا يبقى تحت العامّ فرد من أفراده وتكون الخصوصيات مستوعبة لها، أو يكون على وجه لا يبقى تحته من الأفراد إلّا ما يلزم منه التخصيص المستهجن، أو لا تصير بالتخصيصات المذكورة لا من الأوّل ولا من الثاني بل يبقى تحته بعد التخصيص ما يكون أكثر ممّا خرج عنه أو يساويه على البناء على أنّه ليس من التخصيص المستهجن.
أمّا حكم الثالث فبناءً على ما ذكر معلوم، فيخصّص العامّ بكلّ واحد من الخصوصات بنفسه دون ملاحظة تخصيصه بغيره.
وأمّا الأوّل والثاني، فإن كان بين الخصوصات قطعي فيقدّم في تخصيص العامّ به على الظنّي، لأنّه متيقّن الخروج عن تحت العام، وإن لم يكن بينها قطعي فلابدّ من ترجيح العامّ أو الخصوصات بالسند، لأنّه إذا لم يمكن الجمع الدلالي بين العامّ وبينها تكون النسبة بين العامّ وبينها التباين، وعلى ذلك إن كان الترجيح للخصوصات بأن لا يكون بينها ما هو مرجوح بالنسبة إلى العامّ، أو اختير الخصوصات لفقد المرجّح في أحد الطرفين على الآخر، فلابدّ من طرح العامّ وترك العمل به. وإن كان الترجيح للعامّ أو اختير العامّ لفقد المرجّح فيترك مجموع الخصوصات لا جميعها، لأنّ المعارض للعامّ هو المجموع دون الجميع، وحينئذ يقع التعارض بين الخصوصات لتخصيص العامّ بها بمقدار لا يكون من التخصيص المستهجن، فإن كان بينها ما هو الأرجح الوافي بهذا المقدار يؤخذ به وإلّا فالحكم هو التخيير بالأخذ من الخصوصات إلى حدّ لا يكون الأخذ به مستهجناً، فتدبّر.
ص: 272
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكر: حكم ما إذا كانت النسبة بين المتعارضات متّحدة، سواء كان على وجه العموم المطلق أو على وجه العموم من وجه، ومثاله كما مرّ: أكرم العلماء، ولا تكرم الفسّاق، ويستحبّ إكرام الشعراء، فإنّ نسبة کلّ من الثلاثة مع الآخر العموم من وجه، ولا ريب في أنّه يقع التعارض بينها في العالم الشاعر الفاسق، وحكمه إمّا العمل بالترجيح إن كان بعضها واجداً لموجبه، أو التخيير مطلقاً.
وأمّا إذا كانت النسبة بين المتعارضات متعدّدة، مثل: ما إذا ورد عامّان من وجه كأن يقول: أكرم العلماء، ويستحبّ إكرام العدول، فالنسبة بينهما العموم من وجه، وورد ما هو خاصّ بالنسبة إلى الأوّل، كقوله: لا تكرم فسّاق العلماء، فهل في مثله يؤخذ في الأوّلين - ابتداءً وقبل ورود المخصّص على الأوّل - بالعموم من وجه فيعمل في مادّة اجتماعهما على أحد المبنيين إمّا الأخذ بما فيه الترجيح أو التخيير، أو يخصّص أوّلاً «أكرم العلماء» بقوله: «لا تكرم الفسّاق منهم»، ثم يلاحظ نسبة استحباب إكرام العدول مع العامّ المخصّص وهي العموم المطلق وترتفع به المنازعة في مادّة اجتماع الأوّلين؟ وهذا هو اختيار الشيخ((1)) خلافاً لصاحب الكفاية،((2)) لأنّ ظهور العامّ - كما قلناه - لا ينثلم بالخاصّ، ولا يعارض الخاصّ المنفصل مع العامّ إلّا في حجّيته في الخاصّ لا في ظهوره فيه فتعارض استحباب إكرام العدول مع وجوب «أكرم العلماء» في مادّة اجتماعهما - وهو العالم العادل - باقٍ على حاله وإن خصّص «أكرم العلماء» بقوله: «لا تكرم فسّاقهم».
فإن قلت: في المثال المذكور تخصيص «أكرم العلماء» ب- «لا تكرم فسّاقهم» موجب لتقديم العامّ المخصّص - وهو أكرم العلماء العدول - على استحباب إكرام العدول في
ص: 273
مادّة الاجتماع - وهو العالم العادل - لأنّه لو قدّم استحباب إكرام العدول على إكرام العلماء العدول لا يبقى مورد له، بخلاف أن لو قدّم وجوب إكرام العلماء العدول على استحباب إكرام العدول فإنّه يبقى تحته العدول من غير العلماء، فالأوّل يكون كالنصّ في شموله لأفراده، والثاني ظاهر في شموله لتمام أفراده، فيحمل الظاهر على النصّ.
قلت: نعم، يكون كذلك ولكن هذا ليس من جهة انقلاب النسبة، كما هو ظاهر لا يخفى.
ص: 274
يذكر فيه اُمور:
الأوّل: المزايا المرجّحة لذيها على غيره المعارض له سواء كان ممّا يرجّح الخبر به من جهة راويه كوثاقته وفقاهته وضبطه وحفظه، أو من جهة نفسه كالشهرة الروائية، أو من جهة صدوره كمخالفة العامّة، أو من جهة لفظه ومتنه كالفصاحة والبلاغة، أو من جهة مضمونه كموافقة الكتاب وفتوى الأصحاب، وبالجملة: على القول بالتعدّي عن المزايا المنصوصة إلى غيرها فكلّ ما يوجب مزيّة في أحد الطرفين المتعارضين على الآخر يكون مرجّحاً لسنده على الآخر والتعبّد لصدوره دون الآخر، وحتى مثل موافقة العامّة مرجّح لسند الآخر والتعبّد به بمقتضى الأخبار.
ولا يقاس بمقطوعي الصدور كالمتواترين حيث لابدّ من حمل موافقة العامّة فيهما على جهة الصدور وللتقية. فإنّه خلاف مظنوني الصدور.
لأنّ فيهما لا تعبّد بصدورهما ولا قطع، ولا يدور الأمر بين كون الموافق للعامّة هو الحجّة أو المخالف لهم، حتى يحمل الموافق على صدوره تقيّة، بل فيهما المحكوم بالصدور هو المخالف للعامّة وهو الّذي تعبّدنا الشارع به دون الموافق، فإنّه مطروح لم يثبت صدوره، فلا تصل النوبة إلى كون جهة صدوره التقيّة، لأنّها فرع ثبوت صدوره، فتدبّر.
الأمر الثاني: على القول بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصة لا مجال للبحث في
ص: 275
ملاحظة الترتيب بينها، بل تمام المناط في کلّ منها وترجيح بعضها على بعض حصول الظنّ الأقوى بالصدور، أو بكون مضمونه أقرب إلى الواقع عن غيره.
وأمّا على القول بعدم التعدّي والاقتصار بالمزايا المنصوصة فللبحث فيه مجال.
وقد ذهب بعضهم((1)) إلى لزوم رعاية الترتيب المذكور في الروايات، وأنّ تقدّم بعضها في الذكر على البعض الآخر يكون بالعناية إلى ذلك، فلا يجوز جعل المتأخّر في الذكر في عرض المتقدّم عليه.
نعم، قد وقع بين الروايات ما بظاهرها تعارض في الترتيب المذكور، فلابدّ من حمل ظاهرها على أظهرها ومطلقها على مقيّدها، وإلّا فالحكم التخيير بين الأخذ بأحدهما، أو تساقطهما والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في المسألة.
هذا، وقد أنكر بعضهم كون أكثر ما في الروايات - سيّما المرفوعة والمقبولة - من المرجّحات، فقال بعدم كون الشهرة منها، لأنّ المذكور في المقبولة هو الأخذ بالمجمع عليه، أي الأخذ بما هو معلوم الصدور، لا ترجيح أحد مظنوني الصدور بها على الآخر.
وفرّع على ذلك: عدم إمكان الاستدلال بالمرفوعة ولا بالمقبولة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة، لكون موردهما عليهما الخبرين المشهورين، أي المقطوع صدورهما، فلا يشمل مظنوني الصدور.
وفي الترجيح بصفات الراوي كالأعدلية وغيرها، قال بعدم حجّية المرفوعة. وأمّا المقبولة فالترجيح المذكور فيها بصفات الراوي جعلت من مرجّحات الحكمين لا الروايتين. واستظهر ممّا ذكره عدم صحّة ما في کلام المتأخّرين من ترجيح الصحيحة على الموثّقة.
ص: 276
وبالجملة: تلخّص ممّا ذكره عدم ورود الترجيح بالمرجّحات المذكورة في کلامهم(علیهم السلام) إلّا في ترجيح الموافق للكتاب على المخالف له، وترجيح مخالف العامّة على الموافق لهم، وذلك لخبر صحيح رواه الراوندي بسنده عن الصادق(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) أنّه(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) قال: «إذ ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه».((1)) وهذه الصورة غير مذكورة في المقبولة، فإنّ المذكور فيها صورة حكم الواجد لموافقة الكتاب والفاقد لها، وأيضاً صورة الموافق للعامّة والمخالف لهم.
وعلى کلّ حال، فمن تمسّك بصحيح الراوندي يظهر اختياره الترجيح بموافقة الكتاب على الخبر الفاقد لها وعلى المخالف للعامّة، وبالمخالف للعامّة على الموافق لهم، فلابدّ للقائل بذلك القول بعدم التعدّي من هذه المرجّحات والاقتصار عليها، وحيث لا يقول هو بالتخيير في الأخذ بالمتعارضين، ويرد ما يراه القائل به من الأخبار بالخدشة فيه سنداً أو دلالة، فلابدّ له في غير تلك الموارد الثلاثة المذكورة من القول بتساقط المتعارضين والرجوع إلى ما تقتضيه القواعد.
والذي ينبغي أن يقال: إنّ المراد من المجمع عليه لو كان معلوم الصدور يختلّ نظام السؤال والجواب في المقبولة، فإنّ ما هو الموضوع للسؤال ابتداءً - كما يظهر من جواب الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) - هو تعارض مظنوني الصدور، ولا يرتبط الجواب عنهما بالأخذ بمعلوم الصدور منهما، فلابد أن يكون المراد من المجمع عليه ما أجمع عليه جمع من الرواة بروايته قبال الخبر الّذي رواه من لا يطلق عليه الجمع. فالظاهر من المقبولة أنّ الشهرة
ص: 277
أوّل المرجحات، فإذا لم يكن بينهما ما هو المشهور أو كانا كلاهما مشهورين يكون المرجّح موافقة الكتاب، هذا.
ويظهر من صاحب الكفاية((1)) دعوى أنّ الظاهر من المرفوعة والمقبولة كونهما - كسائر ما يدلّ على الترجيح من الأخبار - بصدد بيان مجرّد ما هو المرجّح وأنّ هذا مرجّح وذاك مرجّح، ولا يستفاد منهما ترجيح ما ذكر أوّلاً على ما ذكر بعده، فالجميع في عرض واحد. والشاهد على ذلك الاقتصار في غير واحد من الأخبار بذكر مرجّح واحد، ومن المستبعد تقييد جميع هذه الروايات بما في المقبولة. وبناءً على ذلك لو كان في أحد المتعارضين مرجّح وفي الآخر مرجّح لابدّ من الرجوع إلى إطلاقات التخيير، إلّا إذا كان أحدهما موجباً للظنّ بصدق مضمونه أو الأقربية إلى الواقع وعلى هذا لا فرق بين المرجّح الجهتي وسائر المرجّحات في الرجوع إلى إطلاقات التخيير إذا كان في أحد المتعارضين المرجّح الجهتي وفي الآخر غيره إلّا إذا كان المرجح الجهتي موجباً لما ذكر من الظنّ بصدوره أو أقربيته إلى الواقع، وإلّا فلا يرجح المرجّح الجهتي على غيره ولا غيره عليه.
وما قيل في وجه الأوّل وهو أنّه إذا كان أحد المتعارضين مخالفاً للعامّة يحصل القطع به بأنّ الموافق لهم إمّا صدر تقيّة أو لم يصدر عنهم(علیهم السلام).
ففيه: أنّه من أين يحصل هذا القطع، مع احتمال عدم صدور المخالف لهم، واحتمال كون الموافق هو حكم الله الواقعي؟ فلم يقل أحد بكون کلّ خبر مخالف لهم قطعي الصدور، فالمدار في الترجيح ليس إلّا ما ذكر.
ووجه القول الثاني: أرجحية المرجّح السندي على المرجّح الجهتي، لأنّه إنّما تصل النوبة إلى المرجّح الجهتي إذا كان المتعارضان من حيث السند سواء لا يرجّح أحدهما
ص: 278
على الآخر، وأمّا بعد وجود المرجّح السندي وتقديم ذي المرجّح على فاقده - يعني على صدوره - يرفع به التعارض، فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى المرجّح الجهتي الّذي يكون الواجد له فاقداً للمرجّح الصدوري الّذي يكون معارضه واجداً له.
وفيه: أنّ هذا يتمّ لو لم يكن المرجّح الجهتي مرجّحاً للصدور، ولكن قد قلنا بأنّ في باب التعارض تمام الكلام يرجع إلى أنّ أيّ الخبرين يكون صادراً وسنده أقوى من الآخر، لا أنّ أيّهما صدر للتقيّة أو لبيان الحكم الواقعي الّذي لا يأتي الكلام فيه إلّا بعد كونهما مقطوعي الصدور أو بحكمه، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الكلام في أقوائيّة أحدهما من حيث الصدور الّذي هو الموضوع للعمل به وإلغاء احتمال خلافه. فالمرجّحات کلّها جهةً أو صدوراً أو مضموناً كانت مرجّحات لصدور ذي المرجّح وطرح الفاقد، فلا تقدّم لأحدها على غيره.
وبعد ذلك کلّه في استشهاد المحقّق الخراساني - بالاقتصار في غير واحد من الأخبار على مرجّح واحد، واستبعاد تقييد جميعها بما في المقبولة - أنّ هذا الاستشهاد لا يصحّ، لأنّه ليست هنا روايات معتبرة - غير صحيح الراوندي - تدلّ على هذا الاقتصار. وعلى هذا، يمكن ترجيح القول برعاية الترتيب بين المرجّحات وتقييد صحيح الراوندي بالمقبولة، وجعل الشهرة أوّل المرجّحات، وأنّ عمدة المرجّحات بعدها ترجع إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامّة على الترتيب بينهما.
الأمر الثالث: لا يخفى أنّ ما ذكر من الخلاف الواقع بينهم في أنّ المرجّح الجهتي هل يساوي غيره ولا ترتيب بينه وبين غيره أو يقدّم هو على غيره كما هو المنقول عن الوحيد البهبهاني،((1)) أو يقدّم غيره عليه كما اختاره الشيخ؟((2)) إنّما يجري إذا كان المرجّح جهتياً لا دلالياً.
ص: 279
وحيث إنّ الموافق لهم يحمل فيه صدوره تقيّة ولا لجهة بيان الواقع، ويحتمل صدوره تورية، والاحتمال الثاني موجب لوهن دلالته على صدوره تقيّة وكون المرجّح جهتياً، فيكون المخالف لهم أظهر في معناه من الموافق لهم، فيحمل الموافق على المخالف من باب حمل الظاهر على الأظهر، وهو مقدّم على جميع المرجّحات. ويؤكّد ذلك احتمال وجوب التورية على مثل الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، هذا.
ويمكن أن يقال: إنّ هذه الأظهرية عقلية ليست عرفية، فإنّ العرف لا يتنبّه بها إلّا بعد الدقّة والتأمّل، لا بالارتكاز والارتجال. مضافاً إلى أنّ ارتكازية ذلك تفيد وتجعل اللفظ في معناه أظهر إذا كان بحيث لا يتحيّر العرف في الحمل على معناه، وأمّا إذا كان المراد من اللفظ مردّداً بين معنيين وكان اللفظ محتمل الأمرين لا يجوز حمله على الآخر المعلوم معناه فيصير مجملاً مردّداً بين كون المرجّح جهتياً أو دلالياً.
وفيه: أنّ معنى حمل الظاهر على الأظهر ليس إلّا هذا، فإنّ الخبر المخالف ظاهر في معناه وهذا غير ظاهر، فيحمل غير الظاهر والمجمل على الظاهر والمبيّن، فتدبّر.
وبعد ذلك کلّه يردّ احتمال كون هذا المرجّح دلالياً صحيح الراوندي، فتأمّل.
ص: 280
المرجّح المضموني ما يوجب الظنّ بأقربية ذيه إلى الواقع من غيره، كالإجماع المنقول والشهرة الفتوائية، من دون أن يكون له دخل في قوّة دليليته أو كاشفيته بالسند أو الدلالة، وهو على قسمين:
أحدهما: ما لم يرد النهي عن العمل به وإلغاء اعتباره ووجوب تركه. وقد وقع الكلام في لزوم الترجيح به وعدمه، بل عدم اعتباره. وما قيل أو يمكن أن يقال في اعتباره وجوه:
أوّلها: ما قيل في وجوب التعدّي من المرجّحات المنصوصة.
وقد عرفت عدم تماميته، وأنّ التعبّد من الشارع بالعمل بذي المرجّح مختصّ بالمنصوص منه.
ثانيها: دخول ذي المرجّح المضموني في القاعدة المجمع عليها،((1)) بتقريب: أنّ المرجّح المضموني ممّا يوجب أقوائية ذيه بالنسبة إلى غيره، فيجب العمل بالدليل الأقوى من غيره، وبعبارة اُخرى: بأقوى الدليلين.
وفيه: أنّ موافقة أحد الدليلين مع الاُمور الخارجية مثل الإجماع المنقول لا يوجب قوّة ذي الموافقة على الدليل الآخر، غاية الأمر يوجب الظنّ بأقربيته إلى الواقع،
ص: 281
والقاعدة المذكورة المجمع عليها أنّها قامت على الأخذ بأقوى الدليلين من جهة دليليّتهما وكشفهما عن الواقع لا من جهة الأقربية إلى الواقع بسبب موافقته مع أمر خارج منه.
ثالثها: أنّ مطابقة أحد الخبرين مع أمر خارجي - يوجب الظنّ بأقربيته إلى الواقع - يوجب الظنّ بوجود خلل في الآخر من حيث الصدور أو جهة الصدور، فيرجع هذا المرجّح الخارجي إلى المرجّح الداخلي.
وفيه منع ذلك فلا توجب المطابقة المذكورة الظنّ بوجود الخلل في الخبر الآخر، فإنّا نرى أنّ الشهرة أو الإجماع المنقول لو قامت على خلاف خبر بلا معارض حجّة لا توجب ظنّ الخلل فيه، لأنّ القطع بالحجية وعدم الخلل فيه لا يمكن أن تجتمع مع الظنّ بالخلل.
فإن قلت: القطع بالحجّية وعدم وجود خلل فيما يعتبر في حجّيته لا يستلزم صدقه واقعاً وعدم خلل واقعي فيه من حيث الصدور أو من حيث الحجّية ولو كان بلا معارض فوجود المرجّح الخارجي مع أحدهما يوجب الخلل في الظنّ بصدق الآخر واقعاً، ويكفي ذلك مزيّة وموجبا لرجحان ذي المرجّح على الآخر.
قلت: لا يعتبر في حجّية الخبر صدقه واقعاً فهو معتبر مع احتمال كذبه، لأنّ فرض اعتبار صدق الخبر الواقعي في حجّيته مع كون معناها حجّة سواء كان صدقاً واقعاً أو كذباً كذلك غير معقول، لا يخفى ما فيه من التهافت.
وثانيهما: ما ورد النهي عنه، ودلّ الدليل بالخصوص على عدم اعتباره، كالقياس.
وحكمه - على القول بعدم جواز الترجيح بما لم يرد النهي عنه - معلوم واضح، لأنّه أولى بعدم الجواز، فلا کلام فيه.
وأمّا على القول بالجواز في القسم الأوّل لتمامية ما ذكر في اعتباره - کلّا أو بعضاً -
ص: 282
فهو وإن يدخل تحت ما دلّ على اعتبار القسم الأوّل، والنسبة بين ما دلّ على النهي عنه ودليل الاعتبار تكون بالعموم من وجه، إلّا أنّ الأخبار الدالّة على النهي عن القياس((1)) مع ما فيها من التأكيد والتشديد وتقبيح العمل به تكون آبية عن التخصيص، واختصاصه بمورد دون مورد، وخطر استعماله في المسألة الشرعية الاُصولية أكثر وأعظم من استعماله في المسألة الفرعية.
والوجوه الّتي قيل بها لجواز التمسّك به في ترجيح أحد الخبرين على الآخر مثل: أنّه ليس العمل بالقياس بل عمل بالخبر((2)) والدليل الّذي طابق مدلوله مدلول القياس، أو أنّ الترجيح به من قبيل العمل لتنقيح الموضوع أي الخبر الحجّة، أو غير ذلك، کلّها ضعيفة لا يخرج بها من إعمال القياس في الدين لوضوح كون الترجيح في هذه المسألة الاُصولية من القياس في الدين أظهر منه وأشنع من القياس في المسألة الفرعية.
ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، والحمد لله الّذي هدانا إلى ولاية أهل البيت عليّ أمير المؤمنين وأولاده الأئمّة المعصومين، وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين.
ص: 283
ص: 284
ص: 285
ص: 286
والكلام فيه موضوعاً وحكماً يقع في مقامين:
إنّ تعريف الاجتهاد بأنّه استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي، مأخوذ من العامّة((1)). فإنّهم لمّا رأوا أنّ ما عندهم من النصوص عن النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لا تكفي في بيان الشريعة والأحكام المبتلى بها الناس إلّا في موارد هي الأقلّ من القليل، وخالفوا ما أوصى النبيّ(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) الاُمّة بالتمسّك بالثقلين (الكتاب والعترة)، وتركوا الأحاديث المتواترة الناصّة على وجوب التمسّك بهما وأنّهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وعلى أن لا يتقدّموا على العترة فيضلّوا، وأن لا يتأخروا عنهم فيهلكوا؛ لجأوا إلى الرجوع إلى غيرهم، واتّبعوا آراء الناس، فأخذوا عن مثل أبي هريرة في دين الله تعالى، ولمّا رأوا أنّ ذلك أيضاً لا يكفي ما يبتلي به الناس في أمر دينهم ودنياهم في أكثر أحكام العبادات من الصلاة والصوم والحجّ والجهاد وغيرها ممّا کلّ واحد منها مشتمل على آلاف من الفروع، وكذا في أحكام المعاملات بأنواعها، وأحكام العائلة والنكاح والطلاق، وأحكام القضاء والحكومة والسياسة والإدارة وغيرها ابتدعوا الاجتهاد بإعمال الرأي والقياس والاستحسان
ص: 287
والاستقراء في دين الله تعالى، فضلّوا وأضلّوا وهلكوا وأهلكوا.
وأمّا شيعة أهل البيت(علیهم السلام) فبفضل تمسّكهم بالثقلين استغنوا عن هذا الاجتهاد وكفاهم ما عندهم - والحمد لله - من علوم ساداتهم الأبرار عترة النبيّ المختار صلوات الله عليهم أجمعين، ممّا رووا عنهم بأسنادهم الذهبية عن رسول الله(صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فلا توجد واقعة أو قضية أو موضوع أو فرع من فروع الأحكام ومسألة في الحلال والحرام، وفي الاُصول والعقائد، ولا آية من الكتاب تحتاج إلى التفسير إلّا وقد بيّن ما يرجع إليها في أحاديثهم ورواياتهم. والحمد لله الّذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
وغورهم في هذه الأحاديث ورجوعهم إليها لمعرفة مداليلها وخاصّها وعامّها ومطلقها ومقيّدها ومتواترها ومستفيضها وآحادها ومسندها ومرسلها وغير هذه، کلّها اجتهاد في فهم الحديث واستحصال للحكم من النصوص، يستخرج بها الحجّة على الأحكام الشرعية منها.
ولا يقاس هذا الاجتهاد بالاجتهاد المصطلح عند القوم الّذي هو منهيّ عنه، فلا يرد على علمائنا وفقهائنا القائمين بهذا الاجتهاد المقدّس اعتراض وإيراد في هذا الاجتهاد، لأنّ هذا لا يكون إلّا ضرباً من الكلام والجدال في اللفظ والاصطلاح.
وبالجملة: التعبير عن الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي، إذا كان المقصود منه الظنّ الحاصل بالاستنباطات الظنّية من القياس والاستقراء الظنّي والمصالح المرسلة، فهو مردود عند جميع فقهائنا. وإذا كان المراد تحصيل الظنّ المعتبر بحكم الشارع مثل الظنّ الحاصل من خبر العادل الثابت حجّيته بالكتاب والسنّة والسيرة، فهو مقبول عند الكلّ يعمل به الجميع سواء سمّي العامل به مجتهداً أو أخبارياً، فالأخباريّ مجتهد والمجتهد أخباري.
وإن شئت فعبّر عن الاجتهاد باستفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي.
ص: 288
فهل من يسمّونه أو سمّى نفسه بالأخباري لا يستفرغ وسعه في تحصيل الحكم الشرعي؟ وهل عمل مثل الشيخ الجليل صاحب الحدائق في كتابه يكون غير استفراغ الوسع لتحصيل الحكم الشرعي؟ إذن فما الوجه لتسمية اختلاف أنظارهم في حجّية بعض الحجج واستنباطاتهم من الأدلّة الّذي ليس بعزيز بين العلماء باختلاف الاُصولي والأخباري؟ وتسمية العلماء بعضهم بالأوّل وبعضهم بالثاني؟
وبالجملة: إن كان بينهم بعض الاختلافات في بعض الصغريات فلا يوجب ذلك تجزئة العلماء بالطائفتين الأخباريّين والاُصوليين.
وبعد ذلك کلّه؛ فإن كان في من يسمّى بالأخباري من لا يقبل ذلك ويريد التباعد والتنازع، فلا نزاع لنا معه وندنو منه لا نتباعد عنه بل ننظر في اجتهاداته في الفقه بعين الاحترام كما ننظر في اجتهاد غيره، وننظر في الحدائق - مثلاً - كما ننظر في الجواهر، ونقبل منهما ما هو الحقّ. ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم.
إعلم: أنّه لا ريب في جواز الاجتهاد واستفراغ الوسع المذكور لمن كان له أهلية ذلك كما يجوز له تحصيل تلك الأهلية.
والظاهر أنّه واجب على الأوّل للأحكام المبتلى بها بنفسه، فلا يجوز له التقليد، للأصل ولانصراف ما دلّ على جوازه، مثل: قوله تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون َ﴾((1)) عنه. فيجب عليه - لغيره، ولحفظ الشريعة القويمة من الاندراس والانطماس - كفاية.
وأمّا الثاني فيجب لنفسه تحصيل قوّة الاجتهاد عند فقد المجتهد الحيّ.
ص: 289
ويمكن أن يقال بعدم الوجوب وجواز الرجوع إلى الأموات.
ويجب عليه أيضاً - لغيره إذا لم يمكن له الرجوع إلى الأموات، ولحفظ الشريعة - بالوجوب الكفائي.
وفي جميع الصور المذكورة إنّما يجب الاجتهاد أو تحصيل القوّة عليه عند عدم إمكان الاحتياط، أو الوقوع به في العسر والحرج.
هذا تمام الكلام في الاجتهاد موضوعاً وحكماً. وقد عرفت أنّه لا فرق فيه بين من يسمّى - عند من ينازع في الاصطلاح أو اللفظ - بالمجتهد أو الأخباري فكلّ في استفراغ الوسع لتحصيل الحجّة على الحكم الشرعي سواء، وإن كان قد يتّفق للبعض عدم وصوله إلى حجّية ما ثبت عند غيره حجّيته كما إذا لم يثبت له تخصيص عامّ، أو تقييد مطلق، أو نحو ذلك. والله هو العالم.
ص: 290
لا يخفى: أنّ الاجتهاد ينقسم إلى المطلق والمتجزّأ.
ولا يخفى أيضاً: أنّ القسم الثاني ممكن الحصول لسهولة الاجتهاد في بعض المسائل.
والأقوى أنّه حجّة للمتجزئ في عمل نفسه. وهل يكون حجّة لغيره؟ الظاهر أنّه كذلك إذا كان المجتهد منحصراً بالمتجزئ، ولا يمكن الاحتياط، والعمل بفتوى الأموات.
وأمّا جواز القضاء له في القضايا الّتي صار عارفاً بأحكامها، فمقتضى الأصل عدم الجواز وعدم نفوذ قضائه.
اللّهمّ إلّا أن يقال بصدق قوله(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «عرف شيئاً من قضايانا» على مقدار صار عارفاً به، فلا يجب أن يكون عارفاً بجميع الأحكام.
وفيه: أنّ المستفاد من «شيئاً» ليس القليل من الأحكام، بل المراد منه الإشارة إلى أنّ ما يعرفه العارفون من علومهم وأحكامهم شيء قليل بالنسبة إلى ما عندهم(علیهم السلام).
وأمّا المجتهد المطلق، فلا ريب في وجوب العمل باجتهاده في عمل نفسه،ولا في نفوذ حكمه وقضائه. وكذا يجوز له الإفتاء والإخبار عمّا استنبطه من الأحكام. كما يجوز له تصدّي الاُمور العامّة، فإنّه القدر المتيقّن للولاية على هذه الاُمور، مضافاً إلى الأدلّة الخاصّة الدالّة على ولاية الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة.
ص: 291
والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين من يرى انفتاح باب العلم والعلمي، ومن يقول بانسداده؛ وذلك لأنّ القائل بالظنّ المطلق والقائل بالظنّ الخاصّ مشتركان في استنباط الأحكام من الأدلّة المعتبرة، وكلّ منهما يتمسّك بالكتاب أو السنّة أو الإجماع على السواء، إلّا أنّ القائل بالظنّ المطلق لا يدّعي القطع بكون مؤدّاه الحكم الواقعي وانتهاء ظنّه إلى العلم بالواقع، والقائل بالظنّ الخاصّ يقول بأنّ ظنّه - الحاصل مثلاً من خبر الواحد - وإن لم يكن قطعاً إلّا أنّ اعتباره مقطوع به. وبالجملة: لا يوجب الاختلاف في وجه اعتبار الظنون الخاصّة اختلافاً في الأدلّة الّتي يتمسّكون بها في الفقه. وأيضاً لا فرق بين الرجوع إلى المجتهد في الأحكام العقلية، كحكم العقل بوجوب تحصيل الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة، والرجوع إلى من يقول باعتبار الظنّ المطلق بحكم العقل.
وخالف صاحب الكفاية، وقال بعدم جواز الرجوع إلى الظنّ المطلقي وعدم نفوذ حكمه، لأنّ الرجوع إليه يكون من رجوع الجاهل إلى الجاهل.((1))
وفيه: أنّ هذا مردود عند العرف، فهل ترى أنّ من رجع إلى مثل المحقّق القمّي في تعلّم الأحكام كان رجوعه إليه رجوع الجاهل! إلى الجاهل وهل إفتاؤه وقضاؤه يكون من غير العارف بشيء من أحكامهم. هذا مضافاً إلى أنّ البحث عن الفرق بين الرجوع إلى الظنّ المطلقي والظنّ الخاصّ يجري على تقرير دليل الانسداد على ما جرى في لسان المتأخّرين، وأمّا لو بنينا على تقرير القدماء - الّذين هم الأصل فيه - فلا يكون للبحث عن الفرق بينهما مجال، فراجع ما كتبناه من السيّد الاُستاذ(قدس سره) في المسألة في فصل تقرير دليل الانسداد على مسلك القدماء. والله هو العالم.
ص: 292
قد قلنا: إنّه لا فرق بين الرجوع إلى المجتهد القائل باعتبار الظنّ المطلق وانسداد باب العلم والعلمي إلى الأحكام وبين الرجوع إلى المجتهد في الأحكام والاُصول العقلية كحكم العقل بوجوب تحصيل الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة، وأصالة البراءة والتخيير والاشتغال، فينبغي أن تجري البحث في جواز تقليد العامّي عن المجتهد فيما استنبطه من الأحكام العقلية، فإذا شكّ المکلّف في حلّيّة الاستفادة من المذياع أو الركوب على الطائرة، وفرضنا عدم وجود عموم أو إطلاق يتمسّك به لحكمهما جوازاً أو حرمةً، فلا ريب في أنّ المجتهد بمقتضى البراءة وقبح العقاب بلا بيان يقول بحلّيّتهما بحكم العقل، وأمّا المقلّد فهل يقلّد المجتهد في الحكم بالحلّيّة أو يجب عليه الاحتياط؟
وجه الإشكال فيه: أنّ رجوع العامّي إلى المجتهد في تلك الموارد - الّتي يكون المرجع فيها الاُصول العقلية - رجوع الجاهل إلى الجاهل. واُجيب عنه: بأنّ رجوع الجاهل إليه فيما هو جاهل فيه والمجتهد عالم به، وهو فقد الأمارات الشرعية في موردها الّذي يكون المقلّد عاجزاً عن الاطّلاع به. وأمّا في تعيين الوظيفة في موارده، وأنّها هل هي البراءة أو الاحتياط، فهو يرجع إلى عقله.
ص: 293
واستشكل في هذا الجواب: بأنّ العامّي عاجز عن تشخيص حكم العقل في موارد فقد الأمارة، إلّا أن يقال بأنّه إن لم يعرف من العقل البراءة أو الاحتياط يعمل بالاحتياط، فإنّ عقله يعرف أنّه يخرج من اشتغال الذمّة بالتكليف بالاحتياط.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ العامّي - إذا كان الأمر المبتلى به من الاُمور العبادية - عاجز عن كيفية الاحتياط وتكرار العمل إلى حصول العلم بفراغ الذمّة.
وقد يجاب عن هذا الإشكال بأنّه يأتي إذا كان دليل جواز التقليد منحصراً فيما يدلّ على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فالمجتهد لا يكون في موارد فقد الأمارة عالماً بالحكم، ولكن يدلّ على الجواز استقرار سيرة العقلاء على الرجوع إلى الخبرة، فالمقلّد يرجع المجتهد في تلك المسائل لكونه من أهل الخبرة. والله هو العالم.
ص: 294
لا ريب في أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة طائفة من المسائل، وإن شئت فقل: إلى طائفة من مسائل طائفة من العلوم، كالعلوم العربية (النحو والصرف واللغة)، وكالتفسير.
واحتياج الفقيه إليها ظاهر، فإنّ جلّ مدارك الأحكام بل کلّها يستفاد من الكتاب والسنّة، ولا ريب في أنّ فهمهما متوقّف على فهم قواعد اللسان العربي. والحاجة إلى التفسير أيضاً ظاهر، لأنّ المعرفة إلى مداليل الآيات محتاجة إلى التفسير المشتمل على أسباب النزول وعموم الكتاب وخصوصه، وسيّما إلى ما ورد عنهم في تفسير الآيات، وإلى معرفة الأحاديث من حيث التواتر والاستفاضة والآحاد وحال أسنادها.
وأيضاً لا ريب أنّ هنا قواعد کلّية يحتاج الفقيه إلى معرفتها ممّا هو مذكور ومجموع سُمّي بالاُصول لبناء المسائل الفقهية عليها.
فما دام لم تكن هذه المسائل مبحوثاً عنها والبناء على ما ينتهي البحث إليها، لا يمكن الاستنباط، فما لم يبن الفقيه في البحث في أنّ الأمر هل ظاهر في الوجوب أو في مجرّد الرجحان على أحد الطرفين؟ لا يمكن له استظهار مراد الشارع من أوامره، وكذا في النواهي. وهكذا في مقدمة الواجب مادام لم يبن في البحث على أنّ وجوب المقدّمة
ص: 295
لازم لوجوب ذيها، لا يمكنه الفتوى بوجوب المقدّمة فيما يعرض له من المسائل الكثيرة. وإذا لم يبحث في أنّ العامّ المخصّص هل هو حجّة في الباقي أو لا؟ ولم يبن على حجّيته، لا يمكن له في العمومات المخصّصة الكثيرة الحكم على حجّية العموم في الباقي، إلّا أن يجدّد البحث في کلّ مسألة من الرأس، فإذا كان ذلك مبحوثاً عنه مستقلّا فيبني عليه في جميع المسائل.
وقس على ذلك سائر الموارد المذكورة في الاُصول.
نعم؛ لا کلام في أنّ بعض المسائل المذكورة في الاُصول غيرمحتاج إليها في الفقه، وليس البحث عنها إلّا استطراداً. إذن فما المانع من جمع هذه القواعد في مجموعة من المسائل، وتسميته بالاُصول، أو بعلم الاُصول؟ وسعيهم للإتيان بتعريف موضوعه على نحو يكون البحث عن تلك المسائل من عوارضه الذاتية، سواء أتوا به أم لم يأتوا به، لا يدخل تدوين هذه المسائل - مجموعة مستقلّة - في البدعة، كما ربما يظنّ ذلك بعض من يسمّي نفسه بالأخباري، وإلّا يكون تدوين مسائل الفقه والتفسير والنحو والصرف واللغة والرجال والتاريخ کلّها بدعة محرمة، فهذا ليس ممّا ينازع فيه العقلاء. والله هو الهادي إلى الصواب.
ص: 296
إعلم: أنّه وإن كان في العامّة، كالعنبري يقول: إنّ کلّ مجتهد مصيب في العقليات، فضلاً عن الفروع. واُورد عليه بأنّه كيف يكون قدم العالم وحدوثه، وإثبات الصانع ونفيه حقّاً؟! إلّا أنّ الظاهر ذهاب أكثرهم إلى التخطئة فيما عليه دليل من الكتاب والسنّة، وإنّما يقول من يقول بالتصويب في الوقائع الّتي لا نصّ فيها ممّا يعملون فيه بالاستحسان والقياس وغيرهما.
وكيف كان، لا إشكال في بطلان التصويب مطلقاً، ولذا قال قوم من المصوّبة: إنّ الحكم في کلّ واقعة واحد معيّن يتوجّه إليه الطلب، إذ لابدّ للطلب من مطلوب، ولكن لم يكلّف المجتهد إصابته، فلذلك كان مصيباً وإن أخطأ ذلك الحكم المعيّن الّذي لم يؤمر بإصابته، بمعنى أنّه أدّى ما کلّف فأصاب ما عليه.
والجواب عن ذلك: أنّ القول بوجوب العمل بالظنّ القياسي والاستحساني ليس معناه - على قول هذا القائل الّذي يتحاشى من القول بالتصويب - إلّا وجوب العمل بالظنّ القياسي مثلاً، فإن أصاب فهو، وإلّا فهو عمل بما عليه وهو العمل بالقياس. وهذا قريب من القول بالتخطئة في الظنون المعتبرة الّتي نصّ الشارع على اعتبارها، كظاهر الكتاب وخبر الواحد، فالنزاع لا يكون بين الطرفين في التخطئة والتصويب،
ص: 297
بل في اعتبار القياس والاستحسان مطلقاً، أو إذا كانا موجباً للظنّ عند الشارع، فالمنكر للقياس والاستحسان يقول بعدم إثبات اعتبار هذه الاُمور إذا لم تكن موجبة للظنّ بالحكم الواقعي الواحد في حقّ الجاهل والعالم، أو مطلقاً. وهذا ما يقوله شيعة الحقّ وقوم من العامّة.
فظهر من ذلك کلّه: أنّنا حيث لا نقول باعتبار مثل القياس والاستحسان والاستقراء في الفقه نستغني عن البحث في التصويب والتخطئة فيها. ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.
ص: 298
إذا زال رأي المجتهد بالتردّد في المسألة، أو تبدّل رأيه برأي جديد، فإمّا يكون مورده وجوب فعل أو حرمة فعل، فلا خلاف في أنّه إذا زال رأيه الأوّل في کلّ منهما وتردّد في حكمه لا يجب عليه بعد ذلك فعل الأوّل ولا ترك الثاني.
وإن كان قد ترك الأوّل أو فعل الثاني قبل زوال رأيه فلا شيء عليه، إلّا إذا قلنا بحرمة التجرّي فيجب عليه التوبة.
وإن تبدّل رأيه من الوجوب إلى الحرمة أو من الحرمة إلى الوجوب يجب عليه البناء على رأيه الجديد في الأعمال اللاحقة، ولا شيء عليه من جهة الأعمال السابقة إن ترك الأوّل أو فعل الثاني، فإنّه أتى بمؤدّى رأيه اللاحق.
وأمّا إن فعل الأوّل فلا شيء عليه تكليفاً، لأنّه كان معذوراً في فعله، لأنّ تكليفه إن كان الوجوب فقد أدّاه، وإن كان تكلّفه الترك فعن عذر فعله.
نعم، يترتّب عليه ما يترتّب عليه من الحكم الوضعي.
وأمّا إن ترك الثاني، أي ما كان يراه حراماً، وتبدّل رأيه بوجوبه، فإن لم يكن لتركه على الاجتهاد الثاني قضاء وتدارك فلا کلام أيضاً، وإن كان يجب عليه تداركه بالقضاء. فالقول بالإجزاء وكونه مكلّفاً بالترك مستلزم للقول بالتصويب المستلزم للدور، وخلاف الإجماع. اللّهمّ إلّا أن يقال: بالسببية في باب الطرق والأمارات.
ص: 299
وإذا كان تكليفه مردّداً بين وجوب هذا الفعل أو حرمة فعل آخر، وأدّى اجتهاده إلى أنّه أحدهما المعيّن، ثم تبدّل رأيه بأنّه الآخر، فهل يجزي الأوّل عن الثاني إن أدّاه قبل تبدّل رأيه مع بقاء وقت الإتيان بالثاني؟ ففيه أيضاً أنّه لا وجه للإجزاء إلّا على القول بالسببية، دون سائر الأقوال.
ومن هنا يظهر أنّه لو كان رأيه السابق عدم وجوب صلاة العيد فتبدّل إلى الوجوب، لا مجال للكلام في أنّه هل يجب عليه البناء فيما مضى عليه على الاجتهاد السابق أو الاجتهاد الجديد.
ومثّلوا أيضاً بما إذا كان رأيه السابق جواز النكاح بالعقد بالفارسية وعقد على إمرأة بالصيغة الفارسية فزال رأيه وتردّد فيه أو تبدّل باشتراط صحّته بالعربية بعد موت المرأة أو بعد طلاقها وانقضاء عدّتها. إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّ في مثل هذا المثال ينفع البحث عمّا يجب أن يبني عليه من الرأي الأوّل أو الثاني في صداقها مثلاً، فإنّه على البناء على الرأي الجديد يتعيّن الصداق في مهر المثل، وعلى البناء على الرأي السابق فهو متعيّن في المهر المسمّى.
ولا يخفى عليك: أنّ الكلام في المسألة إنّما يأتي فيما إذا كان بناء المجتهد على رأيه الأوّل مبنّياً على الاعتماد بالأمارات والاُصول الشرعية، وأمّا إذا كان مبنیّاً على القطع بالحكم فزال وتبدّل بالشكّ أو الظنّ أو القطع بالخلاف، فالظاهر أنّه ليس محلّ الكلام، لعدم احتمال وجود الحكم الظاهري بعد كشف الخلاف بالنسبة إلى الأعمال السابقة، وعدم كونه عاملاً بطريق شرعي. فما يأتي الكلام فيه ما إذا كان ترتيب الأثر على الأعمال السابقة محلّ الابتلاء كالمرأة الّتي هي باقية تحت نكاحه بعد زوال رأيه بجواز العقد الفارسي وقد عقدها به. وكما إذا كان رأيه طهارة عرق الجنب من الحرام ثم زال بعد ما صلّى فيه. وكما إذا كان رأيه وجوب صلاة الجمعة تخييراً أو تعييناً في عصر الغيبة
ص: 300
فصلّاها وتبدّل رأيه بعدم وجوبها واشتراط صحّتها بزمان الحضور وإذن الإمام(عَلَيْهِ السَّلاَمُ). وكما إذا كان لا يرى تنجّس الملاقي للمتنجّس وتوضأ واغتسل به وصلّى، وبعده تبدّل رأيه بتنجّسه.
ويمكن أن يقال: إنّ بعد كشف الخلاف وقيام الحجّة على الرأي الثاني الّذي يكون مطلقاً وغير مقيّد بزمان دون زمان يجب العمل بمقتضاها، ولا وجه للاستناد بالرأي الأوّل الّذي ظهر بطلانه. فيجب عليه تجديد العقد المذكور، وقضاء ما فات عنه من الصلوات، والبناء على تنجّس ما لاقى المتنجّس قبل تبدّل رأيه.
وبالجملة: لا يجزي الإتيان بالأمارة القائمة على أصل التكليف بعد كشف الخلاف عن تكليف آخر، كما أشرنا إليه في مثل ما إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة. كما لا يجزي في متعلّق التكليف إذا كان الحاكم في تشخيصه العرف، كمتعلّقات العقود والإيقاعات والمعاملات ممّا ليس تشخيص مصاديقه مبنيّاً على التعبّد، مضافاً إلى دعوى قيام الإجماع على البناء فيها على رأيه الجديد.
نعم، في العبادات، كالصلاة والصوم والحجّ، إذا كان زوال رأيه أو تبدّله فيما يعتبر في المأمور به شرطاً أو شطراً، كما إذا استقرّ رأيه بالدليل أو الأصل الشرعي على عدم جزئية السورة، أو عدم مانعية كون اللباس في الصلاة من وبر غير مأكول اللحم، أو الملاقي للبول بعد غسله بالماء القليل مرّة واحدة، ثم تبدّل رأيه بعد الصلاة بجزئية السورة، ومانعية كون اللباس من وبر غير المأكول، ومانعية اللباس الملاقي للبول المغسول بالماء القليل مرّة واحدة، لعدم زوال النجاسة بالغسل بالماء القليل مرّة واحدة، يمكن أن يقال بتوسعة موضوع المأمور به وأنّه أعمّ ممّا هو فاقد السورة في حال الجهل بوجوبها وواجدها في حال العلم به، أو هو أعمّ من الواقع في اللباس المجهول تنجّسه والواقع في المعلوم طهارته، فللصلاة المأمور بها فردان فرد لها في حال
ص: 301
الجهل بنجاسة اللباس، وإن شئت قل في حال حكم الشارع بطهارته، وفرد لها في حال علمه بطهارته، وإن شئت فقل: المانع العلم بنجاسة اللباس، لا أنّ العلم بطهارة اللباس شرط في الصلاة. وبعبارة اُخرى: المانع النجاسة المعلومة، لا النجاسة الواقعية، وذلك مقتضى ملاحظة وجوب الأمر بالصلاة، وأنّها لا تسقط بحال حتى في حال الجهل بجزئية السورة مثلاً أو نجاسة اللباس، ومقتضى مثل حديث الرفع((1)) وأصالة الطهارة، فإنّه لو قلنا بالبناء على كشف الخلاف بعد تبدّل الرأي إلى جزئية السورة، أو العلم بوقوع الصلاة في اللباس المتنجّس، يلزم منه سقوط التكليف بالصلاة واقعاً في حال وجوبها عليه ظاهراً، ولا يمكن الالتزام بذلك.
فإن قلت: إنّ ذلك إن يأتي يأتي في الشبهات الموضوعية، فإذا دلّت الأمارة أو الأصل الموضوعي على تحقّق ما هو الشرط أو الجزء، أو دلّت على عدم المانع في لباسه، يمكن أن يقال: إنّه فرد من اللباس الطاهر، أو الطهارة بالماء الطاهر، أو المكان المباح. وأمّا في الشبهة الحكمية، كما إذا شككنا في جزئية السورة، أو اشتراط الصلاة بطهارة اللباس، إذا كان الحكم الواقعي جزئية السورة، واشتراط الصلاة بطهارة اللباس، فالقول بكونها فرداً للصلاة مستلزم للتصويب والدور.
قلت: نعم، لابدّ لدفع ذلك من التمسّك بما ذكرناه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، بأن يقال: إنّ الحكم ينشأ مطلقاً من غير تقيّده بحال العلم وبدون ملاحظة حال العلم والجهل به، وإنّما يريد الحاكم من إنشائه انبعاث العالم به منه. وإن كان يريد بعث الجاهل به يجب عليه التوسّل بأمر آخر كإيجاب الاحتياط على الجاهل، فإذا لم يجب الاحتياط عليه، ولم يسقط تكليفه بطبيعة المأمور به في حال الجهل بالطبيعة الواجدة
ص: 302
لجميع الأجزاء والشرائط، وقامت الأمارة أو الأصل على فردية الفاقد للشرط أو الجزء المشكوك يكون لا محالة هذا فرداً لها، وإن شئت فقل: بمنزلتها ومجزياً عنها، فالحكم على ذلك غير متوقّف على العلم به وإن كان تنجّزه متوقّفاً عليه، فلا دور ولا تصويب، لأنّ حكم الله بطبيعة الصلاة الواجدة للشرائط غير مقيّد بعلم المكلف به، فهو أنشأ للجاهل والعالم على السواء، إلّا أنّه يتنجّز على العالم بالعلم به ولا يتنجّز على الجاهل، ولذا لا منافاة بين كونه محكوماً بحكم هو غير الحكم الّذي لم يتنجّز عليه. وتمام الكلام في باب الإجزاء، وفي باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد مرّ.
ثم لا يخفى عليك: أنّ الفرق بين مسألتنا هذه ومسألة الإجزاء أنّ البحث في الإجزاء يعمّ المجتهد وغيره في الشبهات الموضوعية كالحكمية، وهنا مختصّ بالمجتهد في الشبهات الحكمية، فالبحث في الإجزاء بهذا اللحاظ أعمّ من البحث في مسألة اضمحلال الاجتهاد.
ومن جانب آخر البحث في هذه المسألة، تعمّ ما هو الموضوع للبحث في مسألة الإجزاء وغيره، فالثاني أخصّ من الأوّل، لأنّ البحث هنا في العبادات والمعاملات، والظاهر أنّ بحثهم في الإجزاء يختصّ بالعبادات، بل مطلق الواجبات. وبالجملة النسبة بينهما بالعموم من وجه، فتتداخل المسألتان في
العبادات إذا تبدّل رأي المجتهد، وتتفارقان في غير العبادات إذا تبدّل رأي المجتهد، وفي العبادات في الشبهات الموضوعية. والله هو العالم.
ص: 303
ص: 304
اعلم أنّ ما يصحّ أن يبحث عنه في المبحث المعنون في کلماتهم بالتقليد هو: أنّه هل يجزي للجاهل العمل بقول العالم، أو متابعة العالم؟ وبتعبير آخر: إيجاد العمل على طبق رأي العالم، أو إتيان العمل معتمداً على قول العالم، أو الاعتماد على قول العالم في الخروج عن عهدة التكاليف الإلهية.
ولعلّ التعبير الأخير أولى وأشمل، لأنّه يشمل الاعتماد على قول المجتهد بعد العمل إن وقع موافقاً لفتواه وإن صدر منه غافلاً أو رجاءً، وعلى هذا يكفي في الاعتماد على رأيه علمه به قبل العمل أو حينه أو بعده.
وتسمية کلّ ذلك بالتقليد في الاصطلاح مناسب لمعناه اللغوي، فإنّه تقليد القلادة والفتل على عنق من كان المقلّد مالكاً لأمره، كتقليد الهدي، أو تقليد أمر كالإمارة وحفظ شيء، والعمل بالوصيّة على عهدة الغير وجعله كالقلادة على عنقه فيحتاج إلى قبول المقلّد (بالفتح).
نعم، الإمارة والخلافة والولايات الشرعية - حيث إنّها تجعل على عهدة الأمير والخليفة والوليّ من جانب الله تعالى المالك الحقيقي للجميع - لا تحتاج إلى قبولهم،
ص: 305
لأنّها من جانب الله تعالى كالقلادة مجعولة في عنقهم، لا يمكن لهم ردّها وكذلك في تقليد الهدي ونحوه لا يحتاج إلى القبول.
ويمكن أن يقال: إنّ فتوى المجتهد حجّة من الله تعالى إمضاءً أو تأسيساً على العاميّ، يجب عليه تعهّده والأخذ به والاعتماد عليه، فالفتوى تكون كالقلادة على عنق الجاهل، لا أن يكون عمله قلادة على عنق العالم، فتسميته بالمقلّد أنسب من تسميته بالمقلِّد.
وأمّا جواز رجوع الجاهل إلى العالم إذا لم يتمكّن من الاحتياط ولو من جهة وقوعه في العسر واختلال الأمر، لا يحتاج إلى کلام كثير، بل يعرفه کلّ واحد من العوامّ بفطرته وجبلّته، وقد استقرّ عليه بناء العقلاء ولم يردع عنه الشارع، وسيرة المتشرّعة((1)) المستمرّة عليه، فلا حاجة إلى الاستدلال ببعض الآيات كما أنّه لا حاجة إلى الاستدلال بالروايات((2)) أيضاً وإن كانت تامّة الدلالة على المطلوب، ويدّعى تواترها بالإجمال.
وتوهّم شمول ما يدلّ على عدم جواز اتّباع غير العلم((3)) والذمّ على التقليد((4)) لما ذكر كونه رادعاً عنه، مردود جدّاً، لانصرافه عن مثل متابعة العالم في أحكام الفروع الّتي لا يمكن تكليف عامّة الناس بتعلّمها، لاختلال النظام به. وينجرّ النهي عن متابعة غير العالم بها العالم إلى رفع اليد عن التكاليف الثابتة عليهم. فلابدّ أن يكون ذلك مختصّاً بالاُصول دون الفروع. هذا مضافاً إلى أنّه على فرض القول بشموله
ص: 306
للفروع يكون مخصّصاً بتلك الروايات الكثيرة الدالّة على الجواز، بل وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بالأحكام، وهذا واضح لا ينبغي فيه الارتياب. والله هو الهادي والعالم بالصواب.
ص: 307
إعلم: أنّه لا إشكال في أنّ العالم الواجد لشرائط رجوع الجاهل إليه إذا كان واحداً يجب الرجوع إليه بناءً على وجوب الرجوع إلى الحيّ دون الميّت، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأمّا إذا كانوا متعدّدين، فإن كانوا متساوين في العلم ومتوافقين في الفتوى يجوز الأخذ بما هو رأي الجميع بما أنّه رأيهم، فإنّه أولى بالإجزاء من الاعتماد على أحدهم المعيّن.
وليس المقام كالائتمام بالإمامين في الجماعة الّتي لابدّ وأن تكون بإمام واحد، فإنّه أمر تعبّدي صرف لم تثبت مشروعيته.
وهكذا إذا كانوا مختلفين في العلم متوافقين في الفتوى مع عدم العلم بالأعلم منهم، إلّا أنّ المعيار هنا على فتوى من كان منهم أعلم في الواقع، فالاعتماد يكون على رأي الأعلم الواقعي منهم.
وإذا كانوا متساوين في العلم مختلفين في الفتوى، فإن أمكن الاحتياط ولا ينتهي إلى العسر وما لا يرضى به الشارع، يحتاط، كما إذا كان فتوى أحد المجتهدين على الوجوب والآخر على الجواز والثالث على الاستحباب، أو كان فتوى أحدهم الحرمة والآخر
ص: 308
الكراهة والثالث الجواز. وأمّا إن لم يمكن الاحتياط، كما إذا دار الأمر بين المحذورين من الوجوب أو الحرمة، أو كان الاحتياط موجباً للعسر والحرج، ففيما يوجب العسر يحتاط فيما دون العسر، وفيما يدور بين المحذورين يأخذ برأي أيّهما شاء.
وأمّا إن كانوا مختلفين في العلم والفقه وفي الفتوى، فهل يجب تقليد الأعلم منهم، أو يجوز تقليد غير الأعلم كالأعلم على السواء. والكلام يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في تكليف المقلّد، فلا ريب في أنّه يجب عليه عقلاً إذا احتمل تعيّن تقليد الأعلم أن يبني في المسألة الاُصولية (تقليد الأعلم) على وجوبه. وفي المسائل الفرعية على تقليد من يرى الأعلم جواز تقليده وإن كان هو غير الأعلم، أو يعمل في المسائل الفرعية بالاحتياط بتقليد الأعلم. والوجه في ذلك: حصول القطع ببراءة الذمّة عن التكليف بذلك فإنّه، إمّا يكون الواجب عليه تقليد الأعلم، أو يكون مخيّراً بينه وبين تقليد غيره، فجواز الاكتفاء بالأوّل يقيني، والثاني مشكوك فيه ويكفي ذلك في عدم حجّيته، والقول بجوازه مستلزم لتوقّف الشيء على نفسه أو التسلسل.
المقام الثاني: وهو في بيان حكم المسألة في نفسها، وأنّه بحسب الأدلّة هل حكم الله الواقعي هو وجوب تقليد الأعلم، أو التخيير بينه وبين تقليد غير الأعلم؟ فينبغي النظر في أدلّة الطرفين، فنقول: قد ذكر في الكفاية((1)) من أدلّة عدم جواز تقليد غير الأعلم الأصل.
يمكن أن يكون المراد منه عدم الخروج عمّا في ذمّته بتقليد غير الأعلم، واستصحاب بقاء التكليف. أو أنّ الأصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين، لأنّ الأمر يدور بين الأخذ بما هو معلوم حجّيته وما هو مشكوك
ص: 309
الحجّية، والعقل مستقلّ بوجوب الأخذ بالأوّل إمّا بالبديهة، أو لأنّ الأمر يدور بين الأخذ بالحجّة وما هو ليس بحجّة، أي المشكوك حجّيته إذ يكفي في عدم حجّيته الشكّ في حجّيته.
لا يقال: لم لا يتساقطان بالتعارض؟ كما هو الشأن في باب تعارض الأمارتين الحجّتين.
فإنّه يقال: ليس في باب تعارض الأمارتين الإجماع على وجوب الأخذ بإحداهما فتتساقطان بالتعارض، بخلاف المقام، ومقتضى ذلك وجوب تقليد الأعلم.
فإن قلت: الأصل مقطوع بالدليل، وهو إطلاق ما دلّ من العقل على جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، وعدم ما يمكن أن يكون مقيّداً له في المقام.
قلت: نمنع الإطلاق، لأنّ الأدلّة إنّما صدرت للإرشاد إلى نفس حسن رجوع الجاهل إلى العالم، دون بيان تفاصيله. نعم، لو قلنا بالإطلاق فالظاهر أنّه لا إطلاق فيما يدلّ على تقييده بالأعلم، لأنّه مختصّ بمورده الخاصّ، فيبقى غيره تحت الإطلاق.
وإن قلت: لكنّ السيرة((1)) قد استقرّت من أصحاب الأئمّة(علیهم السلام) على الأخذ بفتوى أحد المخالفَين من دون الفحص عن أعلميته، مع العلم بأعلمية أحدهما.
قلت: نمنع تحقّق السيرة، بل يمكن دعوى سيرة المبالين بالدين على الفحص، فإذا كانوا هم بحكم جبلّتهم وفطرتهم مبالين بفتوى الأعلم المعيّن من بينهما، مقبّحين العمل بفتوى غيره، فكيف يعملون بفتوى أحدهما غير المعلوم أعلميته بدون الفحص عن الأعلم مع العلم بأعلمية أحدهما؟! فتحقّق السيرة على خلاف ذلك في غاية البعد.
إن قلت: الحكم بعدم جواز التقليد من غير الأعلم يوجب العسر للمقلّد والمقلّد،
ص: 310
بل يمكن أن يقال بعدم إمكانه، فكيف يمكن لشخص واحد الجواب عن استفتاءات جميع الاُمّة؟ وكيف يمكن للجميع الوصول إليه؟
قلت: يمكن للجميع أخذ فتاواه من رسالته وكتبه، والناقلين عنه من أهل الثقة، فلا يلزم منه عسر لا على هذا ولا على ذاك.
وهكذا لا يوجب القول بوجوب تقليد الأعلم العسر في تشخيصه، كما أنّه لا عسر في تشخيص المجتهد. وعلى فرض لزوم العسر يجب عليه الاحتياط فيما دونه.
هذا، وقد استدلّ لعدم جواز تقليد غير الأعلم بوجوه: منها: الإجماع.((1))
وردّ: بمنع تحقّقه أوّلاً. ومنع حجّيته على فرض تحقّقه ثانياً، لأنّه من المحتمل المدرك، لاحتمال كون مدرك المجمعين - جميعهم أو بعضهم - الأصل الّذي تقدّم ذكره.
ومنها: الأخبار الدالّة على ترجيح قول الأفقه في صورة المعارضة.((2))
وفيه: أنّها في مقام القضاء والحكم بالموضوع.
ولو سلّم أنّ النزاع والمخاصمة كانت لأجل الشبهة الحكمية من جهة الاختلاف في دين أو ميراث، فلا يدلّ ذلك على أزيد من ترجيح قول الأفضل، لعدم إمكان رفع التخاصم إلّا به.
ولكنّ الإنصاف مع ذلك أنّ هذه الأخبار لا تخلو من الدلالة على وجوب
ص: 311
الأخذ بفتوى الأفضل إذا دار الأمر بين المحذورين، كمقام المرافعة والمخاصمة، وبعدم القول بالفصل، بل القول بعدم الفصل، يقال بوجوب الأخذ بفتوى الأعلم مطلقاً، فتأمّل.
ومنها: إنّ قول الأفضل أقرب من غيره جزماً.((1)) وإن شئت قل: احتمال كونه الواقع أقوى من احتمال قول الفاضل.
والجواب عنه: أنّه ممنوع صغروياً وكبروياً. أمّا من حيث الصغرى: فإنّ مجرد كون القائل بقول أفضل من غيره لا يوجب كون احتمال إصابته إلى الواقع أقوى مطلقاً ولو كان قول غير الأفضل مطابقاً للمشهور أو لقول من هو أعلم منهما من الأموات.
وأمّا من حيث الكبرى: فلأنّ ملاك حجّية قول المجتهد شرعاً - ولو على نحو الطريقية - لم يعلم أنّه لقربه إلى الواقع، حتى يحكم عند المعارضة بوجوب الأخذ بقول الأعلم لأنّه أقرب إلى الواقع، بل يمكن أن يكون ملاك حجّيته أمراً آخر لا يتفاوت فيه كونه من الأعلم أو غيره.
وقد يجاب عن ذلك إمّا بمنع أنّ الكلام في تعارض قول الفاضل مع الأفضل بنفسهما لا بملاحظة ما يقارنهما ويوجب تفصيل أحدهما على الآخر، فيمكن أن يقال بعدم وجوب تقليد الأعلم إذا كان قول الأعلم منهما من الأموات موافقاً لغير الأعلم.
وإمّا بمنع الكبرى، بأنّ حجّية قول المجتهد بأيّ ملاك كان هو في قول الأعلم
ص: 312
أكثر أو أقوى، فلا يجوز مع وجود الأقوى الأخذ بالأضعف، مثلاً: إذا كان الملاك غلبة الإصابة فيمكن دعوى كون ذلك أقوى في قول الأعلم بالنسبة إلى غيره. والله هو الهادي.
ص: 313
إعلم: أنّه لا خلاف بينهم في جواز التقليد عن الحيّ بالنظر إلى نفس هذا الوصف، وإنّما وقع الخلاف بينهم في جواز تقليد الميّت في عرض تقليد الحيّ، فهل يجوز تقليد الميّت مع وجود المجتهد الحيّ؟ هناك صور نبحث عن کلّ منها على حدة.
الاُولى: إذا كان الحيّ والميّت متساويين في العلم متّفقين في الفتوى، فربما يظهر من کلما ت بعضهم((1)) أنّ الحياة شرط في جواز التقليد كالإيمان، فلا يجوز تقليد الميّت وإن كان متساوياً مع الحيّ، بل وإن كان أعلم منه وكانا متّفقين في الفتوى.
ولكنّ الإنصاف أنّه لا دليل على ذلك، وأنّ ما يدلّ على إجزاء التقليد عن الحيّ يشمل التقليد عن الميّت المساوي له إذا كانا متوافقين في الرأي.
الثانية: إذا كانا متساويين في العلم مختلفين في الرأي، فمقتضى الأصل عدم إجزاء تقليد الميّت، وبقاؤه تحت حرمة العمل بغير العلم، وتعيّن تقليد الحيّ لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، فالمتعيّن هو تقليد الحيّ لعدم خلاف في جوازه.
الثالثة: إذا كان الميّت أعلم من الحيّ وكانا مختلفين في الرأي، فلا يخفى أنّ مقتضى
ص: 314
الشكّ في جواز تقليد الميّت واليقين بجواز تقليد الحيّ أيضاً تعيّن تقليد الحيّ، إلّا أنّه يمكن أن يمنع تحقّق اليقين بجواز تقليد الحيّ حينئذ، لمنع تحقّق الإجماع على جواز تقليد الحيّ حتى في هذه الصورة، ولانصراف إطلاق ما يدلّ على وجوب التقليد المدّعي انصرافه إلى الحيّ عن هذه الصورة. فلو لم نقل بوجوب تقليد الميّت الأعلم فلا أقلّ من تردّد الأمر بين تعيّنه، أو التخيير بينه وبين تقليد الحيّ غير الأعلم.
والّذي ينبغي أن يقال: إنّ من بنى على أنّ الأصل حرمة تقليد الميّت وإن كان أعلم وفتواه مخالفاً للحيّ لبنائه على تحقّق الإجماع على جواز تقليد الحيّ مطلقاً فهو، وإلّا فلو منعنا هذا الإطلاق وقلنا بعدم شمول الإجماع لهذه الصورة، ففي جانب جواز التقليد عن الحيّ غير الأعلم أيضاً مقتضى الأصل حرمة تقليده، فاللازم الخروج عن الأصل بالدليل. والدليل على جواز التقليد عن الميّت الأعلم هو:
إطلاق النقل وشموله لتقليد الميّت كالحيّ على حدّ سواء، المقيّد بما إذا كان الحيّ والميّت متساويين أو الحيّ أفضل من الميّت.
والدليل الثاني: عدم الفرق في حكم العقل بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين العالم الحيّ والميّت، سيّما إذا كان الميّت أعلم، لو لم نحكم برجحانه.
والدليل الثالث: الأصل، وهو استصحاب جواز تقليده في حال حياته بعد موته، وهذا يقرّر بوجهين: أحدهما: استصحاب جواز العمل برأيه السابق الّذي كان له في حياته بناءً على انعدام رأيه عند العرف بموته وعدم بقائه.
وثانيهما: استصحاب جواز العمل برأيه الباقي ببقاء نفسه الناطقة بعد موته.
وعلى هذا يكون المخرج من الأصل - الدالّ على حرمة تقليد الميّت ابتداءً إذا كان الميّت أعلم من الحيّ ومخالفاً معه في الرأي - الاُمور الثلاثة:
ص: 315
أحدها: الإطلاق الدالّ على جواز التقليد، المقيّد بالإجماع على عدم جوازه إذا كان الميّت مساوياً للحيّ مخالفاً معه في الفتوى.
وثانيها: عدم الفرق في حكم العقل برجوع الجاهل إلى العالم بين الحيّ والميّت، بل وحكمه برجحان الرجوع إلى الأعلم منهما إذا كانا مختلفين في الرأي. ثالثها: الأصل.
واُجيب عن إطلاق النقل، بمنعه وظهور الروايات في جواز الرجوع إلى الحيّ.
وعن دليل العقل، باستقرار بناء العقلاء على الرجوع إلى الحيّ، ألا ترى أنّك إذا كنت مريضاً ترجع إلى الطبيب الحيّ ولا ترجع إلى كتب الأموات من الأطبّاء.
وعن الأصل، أمّا على التقرير الأوّل، فالجواب عنه: أنّه لابدّ من بقاء الرأي والاعتقاد، ولذا لو زال اعتقاده بجنون أو هرم أو تبدّل الرأي لا يجوز تقليده قطعاً. وبعبارة اُخرى: الإجماع قائم على أنّ، جواز التقليد يدور مدار الرأي الموجود، فلا يكفي مجرّد حدوثه.
وعن التقرير الثاني: فإنّا وإن قلنا ببقاء موضوع الرأي وهو النفس الناطقة وعدم انعدامها بموت الجسد، إلّا أنّه عند العرف تنعدم النفس بموت الجسد، فلا يرى العرف لها بقاءً فضلاً عن رأيه.
بل يمكن أن يقال: إنّ بقاء الرأي على القول ببقاء النفس الناطقة أيضاً ممنوع، فإنّ الرأي إن كان ظنيّ الحصول، كأغلب آراء المجتهدين، فإن كان خلافاً للواقع يرتفع جزماً لكشف خلافه بعد الموت، وإن كان موافقاً للواقع فيزول الظنّ به وينقلب باليقين، فهو مقطوع الارتفاع.
لا يقال: إنّ الفرق بين الظنّ واليقين بالشدّة والضعف.
فإنّه يقال: إنّ الظنّ ضدّ اليقين، فإنّ الظنّ عبارة عن الرجحان المحتمل خلافه، واليقين هو العقيدة الّتي لا تتحمّل احتمال خلافها.
ص: 316
وإن كان الرأي مقطوعاً به فهو مشكوك البقاء، لأنّ بقاءه يدور مدار كونه مطابقاً للواقع وهو مشكوك فيه، مضافاً إلى أنّه لو كان موافقاً للواقع لا وجه للتعبّد ببقائه فلا يجري فيه الاستصحاب، لأنّه التعبد ببقاء ما هو مشكوك البقاء، وعلى تقدير مطابقة الرأي مع الواقع يكون بقاؤه مقطوعاً به لا مشكوكاً فيه.
ويمكن الجواب عمّا ذكر. أمّا عن منع الإطلاق، فلأنّه لا وجه لدعوى انصراف الأدلّة إلى الحيّ وانصرافها عن الميّت، بعد ما نعلم أنّها ليست تأسيسية وأنّ مفادها إمضائية وإرشاد إلى ما يرشد إليه العقل من رجوع الجاهل إلى العالم الّذي ربما يكون ما هو الوجه للرجوع إلى العالم أقوى في الرجوع إلى الميّت من الرجوع إلي الحيّ.
وأمّا المثال بالطبيب والمريض، فقياس مع الفارق، لأنّ المريض العالم بما هي الدواء للداء الفلاني من الطبيب الميّت الأعلم من الحيّ يرجع إلى الطبيب لتشخيص الداء والموضوع، لا لأخذ النسخة والدواء، كما هو واضح.
وأمّا الجواب عن ردّ الأصل - على التقرير الأوّل بزوال الرأي بالهرم والجنون وغيرهما - : عدم صحّة استصحاب جواز التقليد من الرأي الّذي كان له قبل ذلك، فلا يدلّ على عدم جواز استصحابه إذا زال الرأي بموت المجتهد. ولا ملازمة بين زوال الرأي بالهرم والجنون وبين زواله بالموت.
اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّه لا وجه لعدم جواز التقليد من الرأي السابق إذا زال بالهرم أو الجنون إلّا زواله الّذي هو موجود في موته، وحينئذ نمنع تحقّق الإجماع على عدم جواز التقليد من الرأي الزائل بالهرم والجنون أيضاً، كالموت.
وأمّا الجواب عن ردّ الاستصحاب على التقرير الثاني، فيمكن أن يقال: إنّه لا يتفاوت في طريقية الرأي الصادر عن المجتهد إلى الواقع حياته ولا موته، ولا تنعدم هذه الطريقية بموته، بل هو يوجد في الخارج بحدوثه آناً مّا في ذهن المجتهد فهو طريق
ص: 317
إلى الواقع، كان المجتهد حيّاً أو ميّتاً أو ناسياً أو غافلاً منه أو ذاكراً له، لا ينعدم أصلاً. وإن تبدّل إلى آخر فهو موجود في عالم الآراء ينقل ويذكر عنه ويورد عليه ويستدلّ له. غاية ما يقال: إنّ طريقيته، وإن شئت قل حجّيته، تنتفي بتبدل رأيه، ولكن لا تنتفي بنسيانه أو بموت صاحب الرأي، فهو في وعائه الخاصّ طريق إلى الواقع باقية طريقيته لم تزل بعد.
ونتيجة ذلك کلّه: عدم نهوض ما يكون دليلاً على عدم جواز التقليد عن الميّت الأعلم إذا كان رأيه مخالفاً لرأي الحيّ، بل الدليل ناهض على وجوب تقليد الميّت الأعلم.
اللّهمّ إلّا أن يمنع وجوب تقليد الأعلم، سيّما إذا كان الأعلم ميّتاً لاستقرار السيرة على تقليد الحيّ من دون فحص عن فتاوى الأموات.
ولكن غاية ذلك جواز تقليد الحيّ مطلقاً، لا عدم جواز تقليد الميّت مطلقاً وإن كان أعلم من الحيّ. إلّا أن يقال بأنّه بعد ذلك جواز تقليد الميّت مشكوكٌ فيه، لدعواهم الإجماع على عدمه، فيدور الأمر بين تعيّن تقليد الحيّ والتخيير بين تقليده وتقليد الميّت، فالأحوط تقليد الحيّ.
هذا کلّه في التقليد البدوي.
وأمّا حكم تقليد الميّت استمراراً، فكما أنّ في التقليد البدوي إذا كان الحيّ والميّت متساويين في العلم ومختلفين في الفتوى يتعيّن تقليد الحيّ، بل وإن كانا متوافقين في الفتوى فلاحتمال كون اعتبار الحياة في المقلد كاعتبار الإيمان، يكون الحكم في التقليد الاستمراري أيضاً كالحكم في البدوي. فإذا كان الميّت الّذي كان مقلّده مساوياً للحيّ
ص: 318
في العلم مختلفاً معه في الفتوى يتعيّن تقليد الحيّ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير. وكذا إن كانا متوافقين في الفتوى.
وإذا كان الحيّ أفضل من الميّت، فالمتعيّن أيضاً تقليد الحيّ على القول بوجوب تقليد الأعلم، بل مطلقاً. وإذا كان بالعكس، ففي التقليد الابتدائي قد مرّ الكلام فيه. وعلى القول بوجوب تقليد الميّت الأعلم الحكم في الاستمراري أيضاً الوجوب. وعلى القول بعدم جواز التقليد البدوي من الميّت مطلقاً يأتي الكلام في الاستمراري، فهل إذا كان الميّت أفضل من الحيّ أو مساوياً له يجوز - بل يجب على فرض كونه أفضل - البقاء على تقليده أو لا يجوز مطلقاً، ولو كان الميّت أفضل؟
يمكن أن يقال: إنّ في صورة تساويهما في الفضل يدور الأمر بين تعيّن العدول إلى الحيّ، أو التخيير بين البقاء والعدول، فمقتضى الأصل تعيّن العدول.
وأمّا إذا كان الميّت أفضل من الحيّ، وقلنا بعدم اشتراط الحياة في المفتي في التقليد الاستمراري، فالواجب البقاء. وإن قلنا باشتراط الحياة مطلقاً، فالواجب العدول إلى الحيّ حتى في فرض أفضلية الميّت من الحيّ. فالكلام يدور مدار اشتراط الحياة في المفتي - في التقليد الاستمراري - وعدمه، ولا يدور الأمر هنا بين التعيين والتخيير، كما يقال في التقليد الابتدائي: إنّ التقليد من الحيّ مجزٍ مطلقاً سواء كان الميّت أفضل من الحيّ أم لا، وإنّما الكلام في إجزاء تقليد الميّت كالحيّ وعدمه، لأنّ الإجماع إن كان على جواز الاكتفاء بتقليد الحيّ مطلقاً، لم يدّع تحقّقه هنا إذا كان الميّت أعلم من الحيّ.
فهذا - أي وجوب العدول إلى الحيّ أو البقاء إذا كان الميّت أفضل - محلّ النزاع، فالأصل في الطرفين عدم الإجزاء وعدم الخروج عن تحت الأصل الأوّلي الّذي مقتضاه حرمة الاكتفاء بكلّ منهما، فاللازم على هذا الرجوع إلى أدلّة الطرفين، فنقول:
إنّ الدليل العقلي على جواز البقاء وعدم جواز العدول يقرّر: بأنّ العقل الّذي
ص: 319
يوجب على العاميّ والجاهل الرجوع إلى العالم - لا يفصل بين حال موته بعد التقليد منه حال حياته، فهل يمنع العقل من العمل بما أخذ المريض من الطبيب حال حياته وعمل به بمجرّد موته؟ وهل يعدل إلى الطبيب الحيّ المفضول؟ بل نقول: لولا الإجماع المدّعى على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً لقلنا به في التقليد الابتدائي أيضاً. فحكم العقل في جواز الاكتفاء بتقليد العالم مطلق يشمل العالم الميّت والحيّ على السواء، وموجب لتقليد الأعلم منهما إذا كانا مختلفين في الرأي، خرج من هذا الحكم التقليد الإبتدائي بالإجماع.
وأمّا النقل، فلا ريب في أنّه إن لم يشمل التقليد الابتدائي يشمل البقاء عليه بعد موت المجتهد، فهل ترى أنّ الّذي أخذ مثلاً بآية النفر وبنى على ما أخذ ممّن تفقّه في الدين لا يجوز له العمل به إن مات هو بعد الأخذ والعمل به، بل وقبل العمل؟ فإطلاق هذه الأدلّة إن لم يشمل التقليد الابتدائي من الميّت يشمل التقليد الاستمراري. فقولنا: «اسأل عن العالم واعمل برأيه» وإن لم يشمل العالم الميّت والرجوع إلى كتابه إلّا أنّه يشمل بالإطلاق جواز استمرار العمل برأيه بعد موته.
وأمّا الأصل، فما هو المشترك للتقليد الابتدائي والاستمراري الاستدلال بما مرّ في تقرير الأصل للتقليد الابتدائي، فإنّه يشمل الاستمراري، وقد مرّ الكلام فيه. وما هو المشترك بين التقليد الاستمراري والابتدائي ما إذا كان المقلّد أدرك زمان المجتهد، فيقال: إنّ هذا كان له الأخذ برأي فلان في حال حياته فيكون له ذلك حال موته، والكلام فيه كما مرّ في سابقه.
والقسم الثالث من تقرير الأصل يختصّ بالتقليد الاستمراري وهو: استصحاب الأحكام الّتي قلّد الحيّ فيها، مثل استصحاب وجوب السورة أو نجاسة الخمر.
واستشكل فيه بأنّه على القول بحجّية قول المجتهد من باب الطريقية ليس حكم
ص: 320
سابقاً حتى يستصحب، وغاية ما هنا تنجّز الواقع بقوله عند المصادفة، وكونه معذوراً عند المخالفة.
وفيه أوّلاً: أنّ قول المجتهد، أي رأيه المحفوظ عنه بعد موته، كما يمكن أن يكون حجّة من باب الطريقية في حياته يمكن جعله حجّة من باب الطريقية بعد موته، فإذا شككنا في بقاء حجّيته نستصحبها.
فإن قلت: إنّ ما هو الموضوع للحجّية هو الرأي الّذي ينتفي بموته عند العرف وهو الّذي تعلّق به اليقين وهو مقطوع الزوال ليس مشكوك البقاء.
قلت: عند العرف لا يزول رأي الشخص بموته، بل يبقى بعده بوجوده الذهني في الأذهان والكتبي في الكتب، فلا يعتبره العرف کلا رأي وكما لم يكن قبل إبدائه، فهو طريق إلى الواقع بعد موت صاحبه كما كان قبله، وهو مثل الأعلام والعلامات المنصوبة لهداية الناس في الطرق والشوارع لا فرق في طريقيته بين حياة ناصبها وموته.
وثانياً: نقول بأنّ هذا يتمّ على القول بأنّ المجعول بالأمارات الحكم التكليفيّ المولويّ الطريقي، فيستصحب الحكم التقليدي الطريقي المولوي مثل الحكم بنجاسة الخمر. وبعبارة اُخرى: رأي المجتهد بنجاسة الخمر من أسباب عروض حكم النجاسة عليه لا من مقوّماته الّتي يدور بقاء الحكم وعدم، مدار بقائه وعدمه، وإن شئت فقل: إنّه من الحيثيات التعليلية لا التقييدية، فإذا ثبت الحكم بنجاسته يستصحب بعد زوال رأيه المفروض زواله عند العرف لا في الواقع.
وقد اُورد على ذلك بأنّ المعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع، فإذا ثبت كون رأي المجتهد بنجاسة الخمر من أسباب عروض الحكم عليه يجري الاستصحاب المذكور، ولكن من المحتمل بل المقطوع به أنّ رأي المجتهد يكون من مقوّمات هذا الحكم فيزول بزواله والفرض أنّه عند العرف يزول الرأي به بموت المجتهد.
ص: 321
وبعبارة اُخرى إذا كان الرأي من أسباب عروض حكم حرمة العصير عليه يكون تبدّل رأي المجتهد أو زوال رأيه بالموت من ارتفاع الحكم عن موضوعه، فإذا شكکنا فيه نحكم ببقائه بالاستصحاب، بخلاف ما إذا كان من مقوّمات الموضوع، فإنّه بزوال الرأي بالموت ينتفي الحكم أيضاً لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. وفي المقام ولو لم نقل بكون الرأي من مقوّمات الحكم إلّا أنّه لا يمكن ردّ احتماله، كاحتمال كونه من أسباب عروضه، فلا يصحّ استصحاب الحكم لاعتبار إحراز بقاء الموضوع، أي نجاسة الخمر أو حرمة العصير، مع أنّه مشكوك البقاء.
فتلخص من ذلك کلّه: أنّ احتمال عدم كون الأحكام التقليدية حكماً لموضوعاتها بقول مطلق، واحتمال كونها باقياً ببقاء رأي المجتهد يكفي في عدم صحّة إجراء استصحاب الحكم بعد زوال رأي المجتهد بالموت، فتدبّر.
ويمكن أن يقال: إنّ الظاهر كون رأي المجتهد من أسباب عروض الحكم لا من القيود المقوّمة له واحتمال كونه من القيود خلاف الظاهر.
ص: 322
إذا كان المجتهدون متّفقين في العلم وفي الرأي، أو مختلفين في العلم متّفقين في الرأي، أو متّفقين في العلم مختلفين في الرأي، فالعامّي مخيّر في التقليد من أحدهم.
وإذا كانوا مختلفين في الفضل والفتوى، فإن كان الأعلم فيما بينهم معيّناً معلوماً يقلّد منه، وإلّا فإن أمكن العمل بالاحتياط بين الفتاوى فهو مخيّر بين الاحتياط، أو الفحص عمّن هو الأعلم من بينهم، فإن اطّلع عليه فهو، وإلّا فيأخذ بأحوط الأقوال إن كان في البين. وإن لم يمكن الاحتياط فالحكم التخيير في تقليد واحد منهم.
وأمّا إذا كان عالماً باختلافهم في الفضل شاكّاً في اختلافهم في الفتوى، فهل يجب عليه الفحص عن الاختلاف ليأخذ بفتوى الأعلم أو لا؟
استدلّ لوجوب الفحص بأنّ مقتضى الأصل وجوب الفحص أو العمل بالاحتياط بتقليد الأعلم، لأنّه يدور الأمر بين كون التقليد من الأعلم متعيّناً أو مخيّراً فيه، فيتعيّن تقليد الأعلم.
واُجيب عنه بانقطاع الأصل بالسيرة في عصر الأئمّة(علیهم السلام) على وجوب الرجوع إلى الأصحاب مع العلم باختلافهم في الفتوى. مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: إنّ فتوى المجتهد سواء كان فاضلاً أو مفضولاً حجّة وطريق بنفسها إلى الواقع، ووجود مجتهد
ص: 323
آخر سواء كان أعلم منه أو مساوياً له لا يزاحمها، وإنّما تزاحمها الفتوى المخالفة لها من مجتهد آخر، فإذا شككنا فيها فمقتضى الأصل عدمها، مثلاً: إذا أفتى المجتهد بنجاسة الخمر وشكّ في وجود الفتوى بطهارته من مجتهد آخر يستصحب عدمها ويؤخذ بالفتوى بالنجاسة.
لا يقال: لابدّ من الفحص كما في باب الأمارات والاُصول الجارية في الشبهات الحكمية، فكما أنّ جواز العمل بها مقصور بصورة الفحص ولا حجّية لها قبل الفحص، ففي المقام أيضاً لا يجوز العمل بالفتوى قبل الفحص عن المعارض معها.
فإنّه يقال: إنّ اشتراط جواز العمل في باب الأمارات بالفحص ليس بنفسها ولمجرّد احتمال وجود أمارة اُخرى على خلافها، بل يكون للعلم الإجمالي بوجود الأمارات المعارضة والأدلّة في موارد الاُصول، بخلاف مخالفة المفضول مع الفاضل فإنّها ممنوعة بالنسبة إلى المسائل المبتلى بها.
وبالجملة: فرق بين العلم الإجمالي الحاصل للمجتهد الّذي يعلم بوجود المعارضات من أوّل الفقه إلى آخره وهو مبتلى بالاجتهاد والاستنباط والإفتاء من أوّله إلى آخره وبين المقلّد الّذي لا يعلم إجمالاً بمخالفة فتوى الأعلم مع غيره، سيّما إذا كان عاملاً بالاحتياط في مظانّ اختلاف الفتاوى. ومع ذلك لا يترك الاحتياط بالفحص.
هذا کلّه فيما إذا كانوا مختلفين في الفضل وشكّ في اختلافهم في الرأي.
وإذا كانوا مختلفين في الرأي وشكّ في اختلافهم في الفضل، فهل يجب الفحص عن مرتبة کلّ منهم بالنسبة إلى غيره أو لا؟ هناك صور:
الاُولى: أن يحتمل أعلمية أحدهم من غيره واحتمل مساواة الغير معه، ولا يحتمل أفضليته عنه.
ففي هذه الصورة لا يجب الفحص ويجزي تقليد محتمل الأعلمية دون غيره، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير على القول بوجوب تقليد الأعلم.
ص: 324
والفرق بين هذه الصورة وصورة العلم بالاختلاف في الفضل وعدم العلم بالخلاف في الرأي: أنّ في صورة عدم العلم بالخلاف في الرأي لا يعلم بوجود المزاحم للفتوى فلا يجب الفحص ويجزي العمل بفتوى المفضول، وفي صورة العلم بالخلاف عالم بوجود ما يزاحم الحجّية فلابدّ إمّا من الفحص أو العمل بالاحتياط.
الصورة الثانية: أن يكون عالماً باختلافهم مع العلم الإجمالي بكون أحدهما أعلم، لكن يشكّ في أنّه زيد أو عمرو. وهذا من دوران الأمر بين الحجّة واللاحجّة كاشتباه الخبر الصحيح بالضعيف، فإنّه عالم بحجّية فتوى الأعلم - على القول بوجوب التقليد منه - وعدم حجّية فتوى المفضول، فمع عدم إمكان تعيين الحجّة من اللاحجّة فلابدّ له من العمل بأحوط القولين إن كان في البين، وإلّا فالعمل بالاحتياط وترك التقليد، وإن لم يمكن الاحتياط فالحكم التخيير.
الصورة الثالثة: الشكّ في أفضلية کلّ واحد من الأطراف عن غيره وعدم إمكان تعيين الأفضل من بينهم بالفحص. ففي مثل هذه أيضاً الحكم هو الأخذ بأحوط الأقوال إن كان في البين، وإلّا فالعمل بالاحتياط، وإن لم يمكن فهو بالتخيير.
وبالجملة: مع العلم بالاختلاف وكون الأعلم مردّداً بين شخصين أو أشخاص - على القول بوجوب تقليد الأعلم - يجب الفحص عنه، فإن لم يتعيّن هو بالفحص فالحكم على ما ذكر.
والحمد لله أوّلاً وآخراً، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين، ونسأله التوبة وأن يغفر لنا خطايانا وهفواتنا وزلّاتنا وسيّئاتنا، ويجعل عواقب اُمورنا خيراً.
قد تمّ ما رزقنا كتابته في هذا الكتاب في اليوم العاشر من شهر ربيع المولود من العامّ الخامس من العشر الثالث من المأة الخامسة من الألف.
ص: 325
ص: 326
1. القرآن الکریم.
2. نهج البلاغة، الإمام عليّ بن أبي طالب(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، الشریف الرضي، تحقیق وشرح محمد عبده، بیروت، دار المعرفة، 1412ق.
3. الاحتجاج، الطبرسي، أحمد بن عليّ (م. 560ق.)، النجف الأشرف، دار النعمان، 1386ق.
4. الاختصاص، المفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، بیروت، دار المفید، 1414ق.
5. الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، المفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، بیروت، دار المفید، 1414ق.
6. أمان الاُمّة من الضلال والاختلاف، الصافي الگلپایگاني، لطف الله، قم، المطبعة العلمیة، 1397ق.
7. أنوار التنزیل وأسرار التأویل (تفسیر البیضاوي)، البیضاوي، عبد الله بن عمر (م. 685ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1418ق.
8. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار(علیهم السلام)، المجلسي، محمد باقر (م. 1111ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1403ق.
9. بدائع الأفکار فی الاُصول، العراقي، ضیاء الدین (م. 1361ق.)، النجف الأشرف، المطبعة العلمیة، 1370ق.
ص: 327
10. تذکرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.).
11. تفسیر العیّاشي، العیّاشي، محمد بن مسعود (م. 320ق.)، طهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة.
12. التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، الفخر الرازي، محمد بن عمر (م. 606ق.)، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1420ق.
13. تهذیب الأحکام، الطوسي، محمد بن الحسن (م. 460ق.)، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1364ش.
14. التوحید، الصدوق، محمد بن عليّ (م.381ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1398ق.
15. جامع أحادیث الشیعة، البروجردي، السّید حسین (م. 1380ق.)، قم، المطبعة العلمیة، 1399ق.
16. الحاشیة علی کفایة الاُصول، الحجّتي البروجردي، بهاء الدین، تقریرات أبحاث السیّد حسین البروجردي، قم، منشورات إسماعیلیان، 1412ق.
17. الخصال، الصدوق، محمد بن عليّ (م. 381ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1403ق.
18. درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، الخراساني، محمد کاظم (م. 1329ق.)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1410ق.
19. دعائم الإسلام، المغربي، قاضي نعمان بن محمد التمیمي (م.363ق.)، القاهرة، دار المعارف، 1383ق.
20. الذریعة إلی اُصول الشریعة، الشریف المرتضی، عليّ بن الحسین (م. 436ق.).
ص: 328
21. الذریعة إلی تصانیف الشیعة، آغا بزرگ الطهراني، محمد محسن (م. 1389ق.)، بیروت، دار الأضواء، 1403ق.
22. ذکری الشیعة في أحکام الشریعة، الشهید الأوّل، محمد بن مکّي العاملي (م. 786ق.).
23. رياض المسائل، الطباطبائي، السّید علي (م.1231ق.).
24. زبدة الاُصول، البهائي العاملي، محمد بن الحسین (م. 1031ق.)، طهران، الطبعة الحجریة، 1319ق.
25. شرح مختصر الاُصول، الإیجي، عبد الرحمن بن أحمد (م. 756ق.).
26. صحیح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعیل (م. 256ق.)، بیروت، دار الفکر، 1401ق.
27. صحیح مسلم، المسلم النیسابوري، مسلم بن الحجّاج (م. 261ق.)، بیروت، دار الفکر.
28. العدّة في اُصول الفقه، الطوسي، محمد بن الحسن (م.460ق.)، قم، مطبعة ستارة، 1417ق.
29. علل الشرائع، الصدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، النجف الأشرف، المکتبة الحیدریة، 1385ق.
30. العناوین، الحسیني المراغي، میر عبد الفتاح (م. 1250ق.).
31. عوائد الأیام، النراقي، أحمد بن محمد مهدی (م.1245ق.)، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.
32. عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة، ابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن عليّ (م. 880ق.)، قم، مطبعة سيّد الشهداء، 1403ق.
ص: 329
33. غنیة النزوع إلی علمي الاُصول والفروع، ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي (م. 588ق.)، قم، مؤسّسة الإمام الصادق(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، 1417ق.
34. فرائد الاُصول، الأنصاري، مرتضی (م. 1281ق.)، قم، مجمع الفکر الإسلامي، 1419ق.
35. فرائد السمطین، الحموئي، إبراهیم بن محمد (م. 730ق.).
36. الفصول الغرویة في الاُصول الفقهیة، الأصفهاني، محمد حسین بن عبد الرحیم (م. 1254ق.)، قم، دار إحیاء العلوم الإسلامیة، 1404ق.
37. فوائد الاُصول، الخرساني، محمد کاظم (م. 1329ق.)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1407ق.
38. فوائد الاُصول، النائیني، محمد حسین (م. 1355ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1376ش.
39. قواعد الأحکام في معرفة الحلال والحرام، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1413ق.
40. قوانین الاصول، القمي، المیرزا أبو القاسم بن الحسن (م. 1231ق.)، طهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة، 1378ق.
41. الکافي، الکلیني، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363ش.
42. کتاب الصلاة، الأنصاري، مرتضی (م.1281ق.)، قم، الطبعة الحجریة.
43. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء، کاشف الغطاء، جعفر (م. 1228ق.).
ص: 330
44. کفایة الاُصول، الخراساني، محمد کاظم (م. 1329ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث.
45. مبادئ الوصول إلی علم الاُصول، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، قم، المطبعة العلمیة، 1404ق.
46. مجمع البیان في تفسیر القرآن، الطبرسي، فضل بن الحسن (م.548ق.)، طهران، منشورات ناصر خسرو، 1373ش.
47. مجمع الفائدة والبرهان، الأردبیلي، أحمد بن محمد (م. 993ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي.
48. المحاسن، البرقي، أحمد بن محمد (م. 274ق.)، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1370ش.
49. مدارك الأحکام في شرح شرائع الإسلام، العاملي، السّید محمد بن علي (م. 1009ق.).
50. مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، الشهید الثاني، زین الدین بن عليّ العاملي (م. 965ق.)، قم، مؤسّسة المعارف الإسلامیة، 1413ق.
51. مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، میرزا حسین (م. 1320ق.)، بیروت، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1408ق.
52. مشارق الشموس في شرح الدروس ، الخوانساري، حسین بن محمد (م. 1099ق.)، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث.
53. مطارح الأنظار، الکلانتري الطهراني، أبو القاسم بن محمد (م. 1292ق.)، تقریرات شیخ مرتضی الأنصاري، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1404ق.
ص: 331
54. معارج الاُصول، المحقق الحلّي، جعفر بن حسن (م. 676ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام)، 1403ق.
55. معارج الاُصول، المحقّق الحلّي، جعفر بن حسن (م. 676ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام)، 1403ق.
56. معالم الدین وملاذ المجتهدین، العاملي، حسن بن زین الدین (م. 1011ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي.
57. ملاحظات الفرید علی فوائد الوحید، الفرید الگلپایگاني، حسن (م. 1366ق.).
58. من لا یحضره الفقیه، الصدوق، محمد بن علي (م. 381ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1404ق.
59. مناهج الأحکام، القمّي، المیرزا أبو القاسم (م. 1231ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1420ق.
60. المناهل، الطباطبائي، السیّد محمد بن علي (م. 1241ق.).
61. نهایة الأفکار، العراقي، ضیاء الدین (م. 1361ق.)، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1405ق.
62. نهایة الدرایة في شرح الکفایة، الأصفهاني، محمد حسین بن عبد الرحیم (م. 1254ق.)، بیروت، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1429ق.
63. نهایة المرام في علم الکلام، العلّامة الحلّي، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، قم، مؤسّسة الإمام الصادق(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، 1419ق.
64. هدایة المسترشدین في شرح معالم الدین، الأصفهاني، محمد تقي بن عبد الرحیم (م. 1248ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث.
ص: 332
65. الوافیة في اُصول الفقه، الفاضل التوني، عبد الله بن محمد (م. 1071ق.)، قم، مؤسّسة إسماعیلیان، 1412ق.
66. وسائل الشیعة، الحرّ العاملي، محمد بن الحسن (م. 1104ق.)، قم، مؤسّسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1414ق.
67. ينابيع المودّة لذوي القربی، القندوزي، سلیمان بن إبراهیم (م.1294ق.)، دار الأسوة، 1416ق.
ص: 333
ص: 334
الصورة
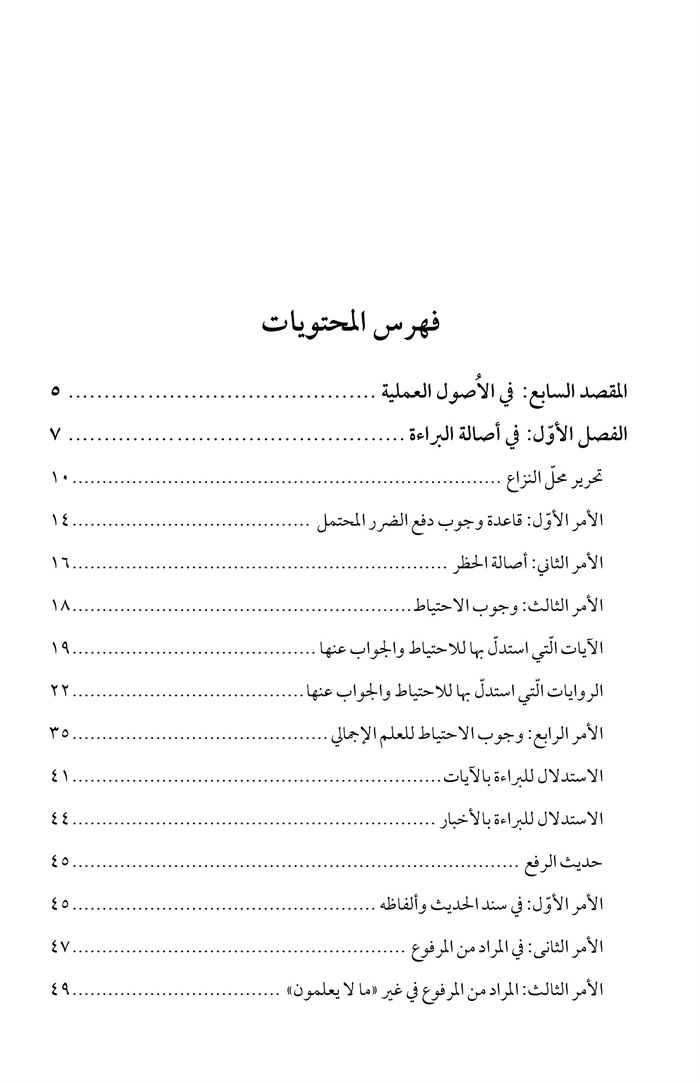
ص: 335
الصورة

ص: 336
الصورة

ص: 337
الصورة

ص: 338
الصورة

ص: 339
الصورة

ص: 340
الصورة

ص: 341
ص: 342
الصورة

ص: 343
الصورة

ص: 344
الصورة

ص: 345
الصورة

ص: 346
الصورة

ص: 347
الصورة

ص: 348
الصورة

ص: 349
الصورة

ص: 350
الصورة

ص: 351
الصورة

ص: 352