الصورة
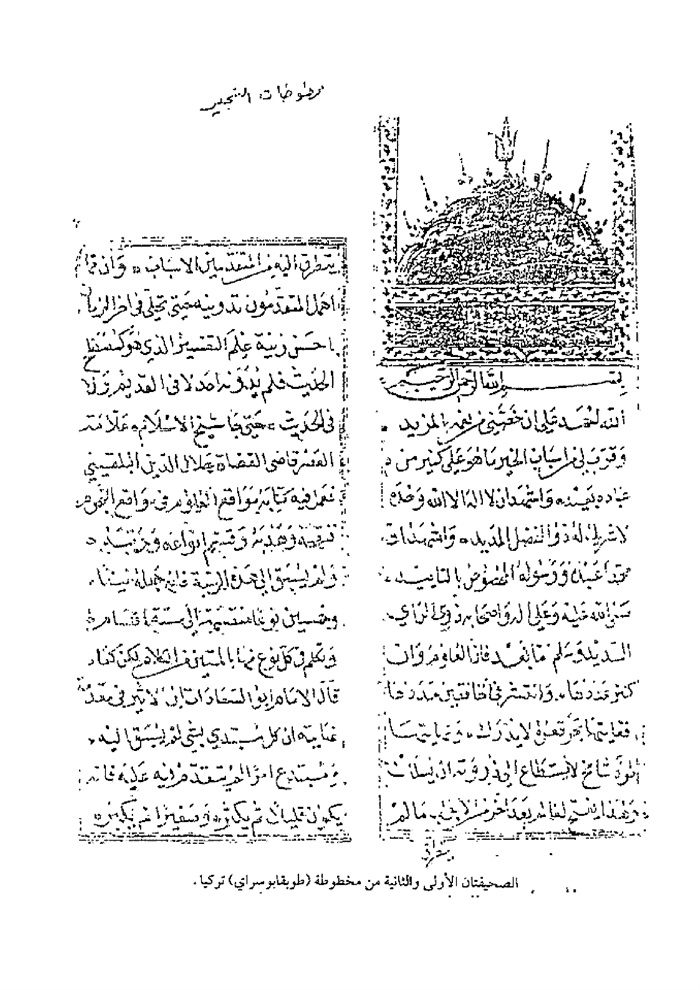
ص: 22
بطاقة تعريف: سيوطي، ابي الفضل
عنوان واسم المؤلف: التحبير في علم التفسير/ ابي الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابي بكر السيوطي
تفاصيل المنشور: بيروت: دار الكتب العلميه، 1408ق=1988م=1367.
خصائص المظهر: 224ص.
حالة الاستماع: في انتظار الإدراج
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1125301
ص: 1
جميع الحقوق محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر .
1421ه- 2001 م
Email: darelfkr@cyberia.net,lb
E-mail: darifikr@cyberia.net.lb
Home Page: www.darelfikr.com.lb
حارة حريك - شارع عبد النور - برقيًا : فكيف - صَرَبَ : 11/7061
تلفون:559903-559902-559901
فاكس : 009611559904
بيروت لبنان
ص: 2
ترجم السيوطي لنفسه في كتابه «حسن المحاضرة» فقال: و إنما ذكرت ترجمتي في هذا الكتاب اقتداء بالمحدّثين قبلي، فقلّ أن ألّف أحد منهم تاريخا إلّا و ذكر ترجمته فيه. و ممّن وقع له ذلك: الإمام عبد الغفّار الفارسي في «تاريخ نيسابور»، و ياقوت الحموي في «معجم الأدباء»، و لسان الدين ابن الخطيب في «تاريخ غرناطة»، و الحافظ تقيّ الدين الفاسي في «تاريخ مكّة»، و الحافظ أبو الفضل ابن حجر في «قضاة مصر»، و أبو شامة في «الروضتين» و هو أورعهم و أزهدهم.
قال السيوطي: ترجمة مؤلّف هذا الكتاب- حسن المحاضرة- عبد الرّحمن بن الكمال أبي بكر بن محمّد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيّوب بن ناصر الدين محمد ابن الشيخ همّام الدين الهمّام الخضيري الأسيوطي.
و أمّا نسبتنا بالخضيري فلا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إلّا «الخضيرية» محلة ببغداد، و قد حدّثني من أثق به أنه سمع والدي رحمه اللّه أن جدّه الأعلى كان أعجميا أو من المشرق، فالظاهر أن النسبة إلى المحلّة المذكورة.
قال السيوطي: و كان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع و أربعين و ثمانمائة، و حملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب، رجل كان من كبار الأولياء بجوار المشهد النفيسي، فبارك عليّ.
و يقول العيدروسي (1): و أحضره والده و عمره ثلاث سنين مجلس شيخ الإسلام ابن حجر مرّة واحدة، و حضر و هو صغير مجلس الشيخ المحدّث زين الدين رضوان العتبي، و درس الشيخ سراج الدين عمر الوردي، ثم اشتغل بالعلم على عدّة مشايخ.
و قال السيوطي: و نشأت يتيما، فحفظت القرآن ولي دون ثماني سنين، ثم حفظت
ص: 3
«العمدة» (1)، و «منهاج الفقه» (2)، و «الأصول» (3)، و «ألفيّة ابن مالك».
و قال العيدروسي (4): و توفي والده ليلة الاثنين خامس صفر سنة خمس و خمسين و ثمانمائة، و جعل الشيخ كمال الدين ابن الهمام وصيّا عليه، فلحظه بنظره و رعايته.
أمّا جدّي الأعلى همّام الدين فكان من أهل الحقيقة، و من مشايخ الطّرق ...
و من دونه كانوا من أهل الوجاهة و الرئاسة، منهم من ولي الحكم ببلده، و منهم من ولي الحسبة بها، و منهم من كان تاجرا في صحبة الأمير شيخون، و بنى مدرسة بأسيوط، و وقف عليها أوقافا، و منهم من كان متجوّلا، و لا أعرف منهم من خدم العلم حقّ الخدمة إلّا والدي.
أما عن أمّه، فيخبرنا السخاوي (5) في الضوء اللامع أن أمّه تركيّة و يقول عنها العيدروسي (6):
أمّ ولد تركيّة.
قال السيوطي: و سافرت بحمد اللّه تعالى إلى بلاد الشام، و الحجاز، و اليمن، و الهند، و المغرب، و التكرور.
و له رحلة داخل مصر أيضا، ذكرها السخاوي في الضوء اللامع (7) فقال: ثم سافر إلى الفيّوم، و دمياط، و المحلّة، فكتب عن جماعة.
ثم قال السيوطي: و لما حججت شربت من ماء زمزم لأمور: منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني، و في الحديث رتبة الحافظ ابن حجر.
أكثر السيوطي عن الأخذ من الشيوخ، و قد جمع أسماءهم في معجم فقال في ذلك: و أما مشايخي في الرواية سماعا و إجازة فكثير، أوردتهم في المعجم الذي جمعتهم فيه، و عدّتهم
ص: 4
نحو مائة و خمسين، و لم أكثر سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهم و هو قراءة الدراية.
قال السيوطي: و شرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة أربع و ستين، فأخذت الفقه و النحو عن جماعة من الشيوخ و أخذت الفرائض عن العلّامة فرضي زمانه الشيخ شهاب الدين الشارمساحيّ الذي كان يقال: إنه بلغ السنّ العالية، و جاوز المائة بكثير و اللّه أعلم بذلك قرأت عليه في شرحه على «المجموع».
و أجزت بتدريس العربية في مستهلّ سنة ست و ستّين، و قد ألّفت في هذه السنة، فكان أوّل شي ء ألّفته «شرح الاستعاذة و البسملة» و أوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني فكتب عليه تقريظا، و لازمته في الفقه إلى أن مات، فلازمت ولده، فقرأت عليه من أول «التدريب» لوالده إلى (الوكالة)، و سمعت عليه من أوّل «الحاوي الصغير» إلى (العدد)، و من أوّل «المنهاج» إلى (الزكاة)، و من أوّل «التنبيه» إلى قريب من (باب الزكاة)، و قطعة من «الروضة» من (باب القضاء)، و قطعة من «تكملة شرح المنهاج» للزركشي و من (إحياء الموات) إلى (الوصايا) أو نحوها، و أجازني بالتدريس و الإفتاء من سنة ست و سبعين و حضر تصديري.
فلما توفي سنة ثمان و سبعين لزمت شيخ الإسلام شرف الدين المناوي، فقرأت عليه قطعة من «المنهاج» و سمعته عليه في التقسيم، إلّا مجالس فاتتني و سمعت دروسا من شرح «البهجة» و من حاشية عليها، و من «تفسير البيضاوي».
و لزمت في الحديث و العربية شيخنا الإمام العلّامة تقي الدين الشّبلي الحنفي، فواظبته أربع سنين، و كتب لي تقريظا على «شرح ألفيّة ابن مالك»، و على «جمع الجوامع في العربية» تأليفي، و شهد لي غير مرّة بالتّقدّم في العلوم بلسانه و بنانه، و رجع إلى قولي مجرّدا في حديث فإنه أورد في «حاشيته على الشفاء» حديث أبي الحمراء في الإسراء، و عزاه إلى تخريج ابن ماجة، فاحتجت إلى إيراده بسنده، فكشفت ابن ماجة في مظنّته فلم أجده، فمررت على الكتاب كله فلم أجده، فاتّهمت نظري، فمررت ثانية فلم أجده، فعدت ثالثة فلم أجده، و رأيته في «معجم الصحابة» لابن قانع، فجئت إلى الشيخ و أخبرته، فبمجرّد ما سمع منّي ذلك أخذ نسخته، و أخذ القلم فضرب على لفظ:
ابن ماجة، و ألحق ابن قانع في الحاشية، فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ في قلبي و احتقاري في نفسي، فقلت: أ لا تصبرون، لعلكم تراجعون؟ فقال: لا إنما قلّدت في قولي: ابن ماجة، البرهان الحلبي، و لم أنفكّ عن الشيخ إلى أن مات.
و لزمت شيخنا العلّامة أستاذ الوجود محيي الدين الكافيجيّ أربع عشرة سنة، فأخذت عنه الفنون من التفسير، و الأصول، و العربية، و المعاني، و غير ذلك، و كتب لي إجازة عظيمة.
و حضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفي دروسا عديدة في «الكشّاف» و «التوضيح» و حاشيته عليه، و «تلخيص المفتاح»، و «العضد».
ص: 5
و شرعت في التصنيف في سنة ستّ و ستّين، و بلغت مؤلّفاتي إلى الآن- أي قبل وفاته باثني عشرة سنة تقريبا- ثلاثمائة كتاب سوى ما غسلته، و رجعت عنه، و يقول العيدروسي (1)، و وصلت مصنفاته نحو الستمائة مصنّفا سوى ما رجع عنه و غسله.
قال السيوطي: و رزقت التبحّر في سبعة علوم: التفسير، و الحديث، و الفقه، و النحو، و المعاني، و البيان، على طريقة العرب و البلغاء، لا على طريقة العجم و أهل الفلسفة.
و دون هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقه، و الجدل، و التصريف، و دونها الإنشاء، و الترسّل، و الفرائض، و دونها القراءات و لم آخذها عن شيخ، و دونها الطبّ. و أمّا علم الحساب فهو أعسر شي ء عليّ، و أبعده عن ذهني، و إذا نظرت في مسألة تتعلّق به فكأنّما أحاول جبلا أحمله.
و قد كنت في مبادئ الطلب قرأت في علم المنطق، ثم ألقى اللّه كراهته في قلبي، و سمعت أنّ ابن الصلاح أفتى بتحريمه فتركته لذلك، فعوّضني اللّه عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم.
و الذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه و النقول التي اطّلعت عليها فيها، لم يصل إليه و لا وقف عليه أحد من أشياخي، فضلا عمّن هو دونهم، و أمّا الفقه، فلا أقول ذلك فيه، بل شيخي فيه أوسع نظرا و أطول باعا.
و يقول: و قد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد؛ و يذكر الباعث على دعواه هذه فيقول: أقول ذلك تحدّثا بنعمة اللّه تعالى لا فخرا، و أيّ شى ء في الدنيا حتّى يطلب تحصيلها بالفخر، و قد أزف الرحيل و بدا الشيب، و ذهب أطيب العمر، و لو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنّفا بأقوالها و أدلّتها النقلية و القياسيّة، و مداركها و نقوضها و أجوبتها، و الموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل اللّه، لا بحولي و لا بقوّتي فلا حول و لا قوّة إلّا باللّه، ما شاء اللّه لا قوّة إلّا باللّه.
يقول نجم الدين الغزّي (2): و لمّا بلغ أربعين سنة من عمره أخذ في التجرّد للعبادة و الانقطاع إلى اللّه تعالى، و الاشتغال به صرفا، و الإعراض عن الدّنيا و أهلها كأنّه لم يعرف أحدا منهم.
و شرع في تحرير مؤلّفاته، و ترك الإفتاء و التدريس، و اعتذر عن ذلك في مؤلّف ألّفه و سمّاه ب «التنفيس» و أقام في روضة المقياس فلم يتحوّل عنها إلى أن مات، لم يفتح طاقات بيته التي على النيل من سكناه.
ص: 6
و كان الأمراء و الاغنياء يأتون إلى زيارته، و يعرضون عليه الأموال النفيسة فيردّها، و أهدى إليه الغوري خصيّا و ألف دينار، فردّ الألف، و أخذ الخصيّ فأعتقه و جعله خادما في الحجرة النبويّة و قال لقاصد السلطان: لا تعدّ تأتينا قطّ بهديّة، فإنّ اللّه تعالى أغنانا عن مثل ذلك، و كان لا يتردّد إلى السلطان و لا إلى غيره، و طلبه مرارا فلم يحضر إليه.
و يقول العيدروسي (1): و حكي عنه أنه قال: رأيت في المنام كأنّي بين يدي النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم فذكرت له كتابا شرعت في تأليفه في الحديث، و هو «جمع الجوامع» فقلت له: أقرأ عليكم شيئا منه؟ فقال لي: هات يا شيخ الحديث، قال: هذه البشرى عندي أعظم من الدنيا بحذافيرها.
يقول ابن العماد (2): و قد اشتهر أكثر مصنّفاته في حياته في أقطار الأرض شرقا و غربا، و كان آية كبرى في سرعة التأليف، حتى قال تلميذه الداودي: عاينت الشيخ و قد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفا و تحريرا، و كان مع ذلك يملي الحديث، و يجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة، و كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث و فنونه، رجالا و غريبا، و متنا و سندا، و استنباطا للأحكام منه، و أخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث قال: و لو وجدت أكثر لحفظته، قال: و لعلّه لا يوجد على وجد الأرض الآن أكثر من ذلك.
و يقول العيدروسي في «النور السافر» (3): و كان يلقّب بابن الكتب؛ لأنّ أباه كان من أهل العلم و احتاج إلى مطالعة كتاب، فأمر أمّه أن تأتي بالكتاب من بين كتبه، فذهبت لتأتي به، فجاءها المخاض و هي بين الكتب، فوضعته.
و يقول نجم الدين الغزي (4): و ألّف المؤلّفات الحافلة الكثيرة الكاملة، الجامعة النافعة، المتقنة المحرّرة، المعتمدة المعتبرة، نيفت عدّتها على خمسمائة مؤلّف، و قد استقصاها الداودي في ترجمته ... و قد اشتهر أكثر مصنّفاته في حياته في البلاد الحجازية، و الشامية، و الحلبية، و بلاد الروم، و المغرب، و التكرور، و الهند، و اليمن، و كان في سرعة الكتابة و التأليف آية كبرى من آيات اللّه تعالى.
و هذه قائمة بأسماء مؤلّفاته تضمنت (281) مؤلّفا ذكرها في كتابه «حسن المحاضرة» قال:
و هذه أسماء مصنّفاتي لتستفاد:
ص: 7
1- الإتقان في علوم القرآن.
2- الدرّ المنثور في التفسير المأثور.
3- ترجمان القرآن في التفسير المسند.
4- أسرار التنزيل يسمّى «قطف الأزهار في كشف الأسرار».
5- لباب النقول في أسباب النزول.
6- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن.
7- المهذّب فيما وقع في القرآن من المعرّب.
8- الإكليل في استنباط التنزيل.
9- تكملة تفسير الشيخ جلال الدين المحلّي.
10- التحبير في علوم التفسير.
11- حاشية على تفسير البيضاويّ.
12- تناسق الدّرر في تناسب السور.
13- مراصد المطالع في تناسب المقاطع و المطالع.
14- مجمع البحرين و مطلع البدرين في التفسير.
15- مفاتح الغيب في التفسير.
16- الأزهار الفائحة على الفاتحة.
17- شرح الاستعاذة و البسملة.
18- الكلام على أوّل الفتح، و هو تصدير ألقيته لمّا باشرت التدريس بجامع شيخون بحضرة شيخنا البلقينيّ.
19- شرح الشاطبية.
20- الألفيّة في القراءات العشر.
21- خمائل الزهر في فضائل السّور.
22- فتح الجليل للعبد الذليل في الأنواع البديعيّة المستخرجة من قوله تعالى: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا .. الآية، و عدّتها مائة و عشرون نوعا.
23- القول الفصيح في تعيين الذبيح.
ص: 8
24- اليد البسطى في الصلاة الوسطى.
25- معترك الأقران في مشترك القرآن.
26- كشف المغطّى في شرح الموطّا.
27- إسعاف المبطّأ برجال الموطا.
28- التوشيح على الجامع الصحيح.
29- الديباج على صحيح مسلم بن الحجّاج.
30- مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود.
31- شرح ابن ماجة.
32- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي.
33- شرح ألفية العراقيّ، الألفيّة و تسمّى «نظم الدّرر في علم الأثر» و شرحها يسمّى «قطر الدّرر».
34- التهذيب في الزوائد على التقريب.
35- عين الإصابة في معرفة الصحابة.
36- كشف التلبيس عن قلب أهل التدليس.
37- توضيح المدرك في تصحيح المستدرك.
38- اللئالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة.
39- النكت البديعات على الموضوعات.
40- الذيل على القول المسدّد.
41- القول الحسن في الذبّ عن السّنن.
42- لبّ اللّباب في تحرير الأنساب.
43- تقريب الغريب.
44- المدرج إلى المدرج.
45- تذكرة المؤتسي بمن حدّث و نسي.
46- تحفة النابه بتلخيص المتشابه.
47- الروض المكلّل و الورد المعلّل في المصطلح.
48- منتهى الآمال في شرح حديث إنّما الأعمال.
ص: 9
49- المعجزات و الخصائص النبويّة.
50- شرح الصدور بشرح حال الموتى و القبور.
51- البدور السافرة عن أمور الآخرة.
52- ما رواه الواعون في أخبار الطاعون.
53- فضل موت الأولاد.
54- خصائص يوم الجمعة.
55- منهاج السنّة، و مفتاح الجنّة.
56- تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظلّ العرش.
57- بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال.
58- مفتاح الجنّة في الاعتصام بالسنّة.
59- مطلع البدرين فيمن يؤتى أجرين.
60- سهام الإصابة في الدعوات المجابة.
61- الكلم الطيّب.
62- القول المختار في المأثور من الدعوات و الأذكار.
63- أذكار الأذكار.
64- الطبّ النبويّ.
65- كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة.
66- الفوائد الكامنة في إيمان السيّدة آمنة، و يسمّى أيضا «التعظيم و المنّة في أنّ أبويّ النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم في الجنّة».
67- المسلسلات الكبرى.
68- جياد المسلسلات.
69- أبواب السعادة في أسباب الشهادة.
70- أخبار الملائكة.
71- الثغور الباسمة في مناقب السيّدة آمنة.
72- مناهج الصّفا في تخريج أحاديث الشّفا.
73- الأساس في مناقب بني العبّاس.
ص: 10
74- درّ السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة.
75- زوائد شعب الإيمان للبيهقي.
76- لمّ الأطراف و ضمّ الأتراف.
77- إطراف الأشراف بالإشراف على الأطراف.
78- جامع المسانيد.
79- الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة.
80- الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة.
81- تخريج أحاديث الدرّة الفاخرة.
82- تخريج أحاديث الكفاية يسمّى تجربة العناية.
83- الحصر و الإشاعة لأشراط الساعة.
84- الدّرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة.
85- زوائد الرجال على تهذيب الكمال.
86- الدرّ المنظّم في الاسم المعظّم.
87- جزء في الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم.
88- من عاش من الصحابة مائة و عشرين.
89- جزء في أسماء المدلّسين.
90- اللمع في أسماء من وضع.
91- الأربعون المتباينة.
92- درر البحار في الأحاديث القصار.
93- الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة.
94- المرقاة العليّة في شرح الأسماء النبويّة.
95- الآية الكبرى في شرح قصّة الإسراء.
96- أربعون حديثا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر.
97- فهرست المرويّات.
98- بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد.
99- أزهار الآكام في أخبار الأحكام.
ص: 11
100- الهبة السنيّة في الهيئة السنيّة.
101- تخريج أحاديث شرح العقائد.
102- فضل الجلد.
103- الكلام على حديث ابن عبّاس: «احفظ اللّه يحفظك»، و هو تصدير ألقيته لمّا ولّيت درس الحديث بالشيخونية.
104- أربعون حديثا في فضل الجهاد.
105- أربعون حديثا في رفع الدين في الدعاء.
106- التعريف بآداب التأليف.
107- العشاريّات.
108- القول الأشبه في حديث: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه».
109- كشف النقاب عن الألقاب.
110- نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير.
111- من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة.
112- ذمّ زيارة الأمراء.
113- زوائد نوادر الأصول للحكيم الترمذي.
114- تخريج أحاديث الصّحاح يسمّى فلق الصباح.
115- ذمّ المكس.
116- آداب الملوك
117- الأزهار الغضّة في حواشي الروضة.
118- الحواشي الصغرى.
119- مختصر الروضة يسمّى القنية.
120- مختصر التنبيه، يسمّى الوافي.
121- شرح التنبيه.
122- الأشباه و النظائر.
123- اللوامع و البوارق في الجوامع و الفوارق.
ص: 12
124- نظم الرّوضة يسمّى الخلاصة.
125- شرحه يسمى رفع الخصاصة.
126- الورقات المقدّمة.
127- شرح الروض.
128- حاشية على القطعة للإسنوي.
129- العذب السلسل في تصحيح الخلاف المرسل.
130- جمع الجوامع.
131- الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع.
132- مختصر الخادم؛ يسمى «تحصين الخادم».
133- تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع.
134- شرح التدريب.
135- الكافي، زوائد المهذّب على الوافي.
136- الجامع في الفرائض.
137- شرح الرحبيّة في الفرائض.
138- مختصر الأحكام السلطانية للماورديّ.
139- الظفر بقلم الظفر.
140- الاقتناص في مسألة التماصّ.
141- المستطرفة في أحكام دخول الحشفة.
142- السلالة في تحقيق المقر و الاستحالة.
143- الروض الأريض في طهر المحيض.
144- بذل العسجد لسؤال المسجد.
145- الجواب الحزم عن حديث التكبير جزم 146- القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة.
147- ميزان المعدلة في شأن البسملة.
148- جزء في صلاة الضحى.
ص: 13
149- المصابيح في صلاة التراويح.
150- بسط الكفّ في إتمام الصف.
151- اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة.
152- وصول الأماني بأصول التهاني.
153- بلغة المحتاج في مناسك الحاج.
154- السّلّاف في التفصيل بين الصلاة و الطواف.
155- شدّ الأثواب في سدّ الأبواب في المسجد النبوي.
156- قطع المجادلة عند تغيير المعاملة.
157- إزالة الوهن عن مسألة الرهن.
158- بذل الهمّة في طلب براءة الذمّة.
159- الإنصاف في تمييز الأوقاف.
160- أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب.
161- الزّهر الباسم فيما يزوّج فيه الحاكم.
162- القول المضي في الحنث في المضي.
163- القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق.
164- فصل الكلام في ذمّ الكلام.
165- جزيل المواهب في اختلاف المذاهب.
166- تقرير الإسناد في تيسير الاجتهاد.
167- رفع منار الدين و هدم بناء المفسدين.
168- تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء.
169- ذمّ القضاء.
170- فصل الكلام في حكم السلام.
171- نتيجة الفكر في الجهر بالذّكر.
172- طيّ اللسان عن ذمّ الطيلسان.
173- تنوير الحلك في إمكان رؤية النبيّ و الملك.
174- أدب الفتيا.
ص: 14
175- إلقام الحجر لمن زكّى سباب أبي بكر و عمر.
176- الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم.
177- الحجج المبينة في التفضيل بين مكّة و المدينة.
178- فتح المغالق من أنت طالق.
179- فصل الخطاب في قتل الكلاب.
180- سيف النظّار في الفرق بين الثبوت و التكرار.
181- شرح ألفيّة ابن مالك يسمّى البهجة المضيّة في شرح الألفيّة.
182- الفريدة في النحور و التصريف و الخط.
183- النكت على الألفيّة و الكافية و الشافية و الشذور و النزهة.
184- الفتح القريب على مغني اللبيب.
185- شرح شواهد المغني.
186- جمع الجوامع.
187- شرحه يسمى همع الهوامع.
188- شرح الملحة.
189- مختصر الملحة.
190- مختصر الألفيّة و دقائقها.
191- الأخبار المرويّة في سبب وضع العربية.
192- المصاعد العليّة في القواعد النحويّة.
193- الاقتراح في أصول النحو و جدله.
194- رفع السّنة في نصب الزنة.
195- الشمعة المضيئة.
196- شرح كافية ابن مالك.
197- درّ التاج في إعراب مشكل المنهاج.
198- مسألة ضربي زيدا قائما.
199- السلسلة الموشحة.
ص: 15
200- الشهد.
201- شذا العرف في إثبات المعنى للحرف.
202- التوشيح على التوضيح.
203- السيف الصقيل في حواشي ابن عقيل.
204- حاشية على شرح الشذور.
205- شرح القصيدة الكافية في التصريف.
206- قطر الندا في ورود الهمزة للندا.
207- شرح تصريف العزّى.
208- شرح ضروريّ التصريف لابن مالك.
209- تعريف الأعجم بحروف المعجم.
210- نكت على شرح الشواهد للعيني.
211- فجر الثمد في إعراب أكمل الحمد.
212- الزند الوريّ في الجواب عن السؤال السكندريّ.
213- شرح لمعة الإشراق في الاشتقاق.
214- الكواكب الساطع في نظم جمع الجوامع.
215- شرحه.
216- شرح الكوكب الوقّاد في الاعتقاد.
217- نكت على التلخيص يسمى الإفصاح.
218- عقود الجمان في المعاني و البيان.
219- شرحه.
220- شرح أبيات تلخيص المفتاح.
221- مختصره.
222- نكت على حاشية المطوّل لابن الفنريّ رحمه اللّه تعالى.
223- حاشية على المختصر.
224- البديعيّة.
ص: 16
225- شرحها.
226- تأييد الحقيقة العليّة و تشييد الطريقة الشاذليّة.
227- تشييد الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان.
228- درج المعالي في نصرة الغزالي على المنكر المتغالي.
229- الخبر الدالّ على وجود القطب و الأوتاد و النجباء و الأبدال.
230- مختصر الإحياء.
231- المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة.
232- النقاية في أربعة عشر علما.
233- شرحها.
234- شوارد الفوائد.
235- قلائد الفرائد.
236- نظم التذكرة، و يسمى الفلك المشحون.
237- الجمع و التفريق في الأنواع البديعية.
...- تاريخ الصحابة و قد مرّ ذكره (1).
238- طبقات الحفّاظ.
239- طبقات النّحاة الكبرى.
240- و الوسطى.
241- و الصغرى.
242- طبقات المفسّرين.
243- طبقات الأصوليّين.
244- طبقات الكتّاب.
245- حلية الأولياء.
246- طبقات شعراء العرب.
ص: 17
247- تاريخ مصر [أي حسن المحاضرة]:
248- تاريخ الخلفاء.
249- تاريخ أسيوط.
250- معجم شيوخي الكبير يسمّى «حاطب ليل و جارف سيل».
251- المعجم الصغير يسمّى «المنتقى».
252- ترجمة النووي.
253- ترجمة البلقيني.
254- الملتقط من الدّرر الكامنة.
255- تاريخ العمر؛ و هو ذيل على إنباء الغمر.
256- رفع البأس عن بني العبّاس.
257- النفحة المسكيّة و التحفة المكيّة، على نمط عنوان الشرف.
258- درر الكلم و غرر الحكم.
259- ديوان خطب.
260- ديوان شعر.
261- المقامات.
262- الرحلة الفيّومية.
263- الرحلة المكيّة.
264- الرحلة الدمياطية.
265- الوسائل إلى معرفة الأوائل.
266- مختصر معجم البلدان.
267- ياقوت الشماريخ في علم التاريخ.
268- الجمانة، رسالة في تفسير ألفاظ متداولة.
269- مقاطع الحجاز.
270- نور الحديقة من نظم القول.
271- المجمل في الردّ على المهمل.
272- المنى في الكنى.
ص: 18
273- فضل الشتاء.
274- مختصر تهذيب الأسماء للنوويّ.
275- الأجوبة الزكيّة عن الألغاز السبكيّة.
276- رفع شأن الحبشان.
277- أحاسن الأقباس في محاسن الاقتباس.
278- تحفة المذاكر في المنتقى من تاريخ ابن عساكر.
279- شرح بانت سعاد.
280- تحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء.
281- قصيدة رائيّة.
282- مختصر شفاء الغليل في ذمّ الصاحب و الخليل ا ه.
و للمزيد راجع فهرست مؤلّفات السيوطي مخطوطة محفوظة في الجامعة الأمريكية- بيروت.
يقول نجم الدين الغزي (1): و كانت وفاته رضي اللّه تعالى عنه في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة و تسعمائة في منزله بروضة المقياس، بعد أن تمرّض سبعة أيام، بورم شديد في ذراعه الأيسر، و قد استكمل من العمر إحدى و ستين سنة و عشرة أشهر و ثمانية عشر يوما و كان له مشهد عظيم، و دفن في حوش قوصون خارج باب القرافة، و صلّي عليه غائبة بدمشق بالجامع الأموي يوم الجمعة ثامن رجب سنة إحدى عشرة المذكورة، قيل أخذ الغاسل قميصه و قبّعه، فاشترى بعض الناس قميصه من الغاسل بخمسة دنانير للتبرّك به، و باع قبّعه بثلاثة دنانير لذلك أيضا ورثاه عبد الباسط بن خليل الحنفي في قصيدة طويلة يقوله:
مات جلال الدين غيث الورى*** مجتهد العصر إمام الوجود
و حافظ السنّة مهدي الهدى ***و مرشد الضال بنفع يعود
فيا عيوني انهملي بعده*** و يا قلوب انفطري بالوقود
و أظلمي يا دنيا إذ حق ذا ***بل حقّ أن ترعد فيك الرعود.
ص: 19
التعريف بكتاب التحبير (1) قال حاجي خليفة في كشف الظنون: مجلد أوله أحمد اللّه على أن خصني من نعمه بالمزيد ... الخ ضمّن فيه ما ذكره البلقيني في مواقع العلوم و جعله مائة نوع و نوعين، و فرغ في رجب سنة 872 ه ثم صنف «الإتقان» و أدرجه فيه.
و «الإتقان في علوم القرآن» (2) مجلد أوله: الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب الخ ... للشيخ جلال الدين السيوطي- المتوفى 911 ه. و هو أشبه آثاره و أفيدها، ذكر فيه تصنيف شيخه الكافيجي و استصغره، و مواقع العلوم للبلقيني و استقله.
ثم إنه وجد للبرهان للزركشي كتابا جامعا بعد تصنيفه «التحبير» فاستأنف و زاد عليه ثمانين نوعا و جعله مقدمة لتفسيره الكبير الذي شرع فيه و سماه «مجمع البحرين».
قال: و في غالب الأنواع تصانيف مفردة.
اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين الأولى: مصورة من مكتبة «طوب قبوسراي» في استانبول بتركيا رقم 560، عدد أوراقها 232. خطها نسخي جميل، مضبوط بالشكل. و في آخرها تاريخ تأليف الكتاب سنة 872 ه و تاريخ النسخ سنة 1116 ه.
و اعتبرنا هذه النسخة هي النسخة الأم.
الثانية: نسخة دار الكتب المصرية رقم: 73- تفسير- تيمور، و هذه النسخة سقيمة، و خطها قريب من الرقعي المستعجل. و فيها اضطراب بترتيب الأوراق. و عليها تملك سنة 1260 ه. و تاريخ النسخ سنة 981 و اعتبرنا هذه النسخة نسخة مساعدة في التحقيق.
و لم نشر إلى مواضع الاختلاف بين النسختين إلا في مواطن قليلة اعتبرناها ضرورية.
ص: 20
التعريف بكتاب التحبير(1)
قال حاجي خليفة في كشف الظنون: مجلد أوله أحمد الله على أن خصني من نعمه بالمزيد الخ ضمّن فيه ما ذكره البلقيني في مواقع العلوم وجعله مائة نوع ونوعين، وفرغ في رجب سنة 872ه_ ثم صنف «الإتقان» وأدرجه فيه.
و «الإتقان في علوم القرآن» (2) مجلد أوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الخ للشيخ جلال الدين السيوطي المتوفى 911ه_. وهو أشبه آثاره وأفيدها، ذكر فيه تصنيف شيخه الكافيجي واستصغره، ومواقع العلوم للبلقيني واستقله.
ثم إنه وجد للبرهان للزركشي كتابا جامعا بعد تصنيفه «التحبير» فاستأنف وزاد عليه ثمانين نوعا وجعله مقدمة لتفسيره الكبير الذي شرع فيه وسماه «مجمع البحرين».
قال: وفي غالب الأنواع تصانيف مفردة.
التعريف بالمخطوطات
اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين الأولى: مصورة من مكتبة «طوب قبوسراي» في استانبول بتركيا رقم 560، عدد أوراقها 232. خطها نسخي جميل، مضبوط بالشكل. وفي آخرها تاريخ تأليف الكتاب سنة 872ه_ وتاريخ النسخ سنة 1116ه_.
واعتبرنا هذه النسخة هي النسخة الأم.
الثانية: نسخة دار الكتب المصرية رقم: 73تفسير تيمور، وهذه النسخة سقيمة، وخطها قريب من الرقعي المستعجل. وفيها اضطراب بترتيب الأوراق. وعليها تملك سنة 1260ه_. وتاريخ النسخ سنة 981واعتبرنا هذه النسخة نسخة مساعدة في التحقيق.
ولم نشر إلى مواضع الاختلاف بين النسختين إلا في مواطن قليلة اعتبرناها ضرورية.
ص: 21
الصورة
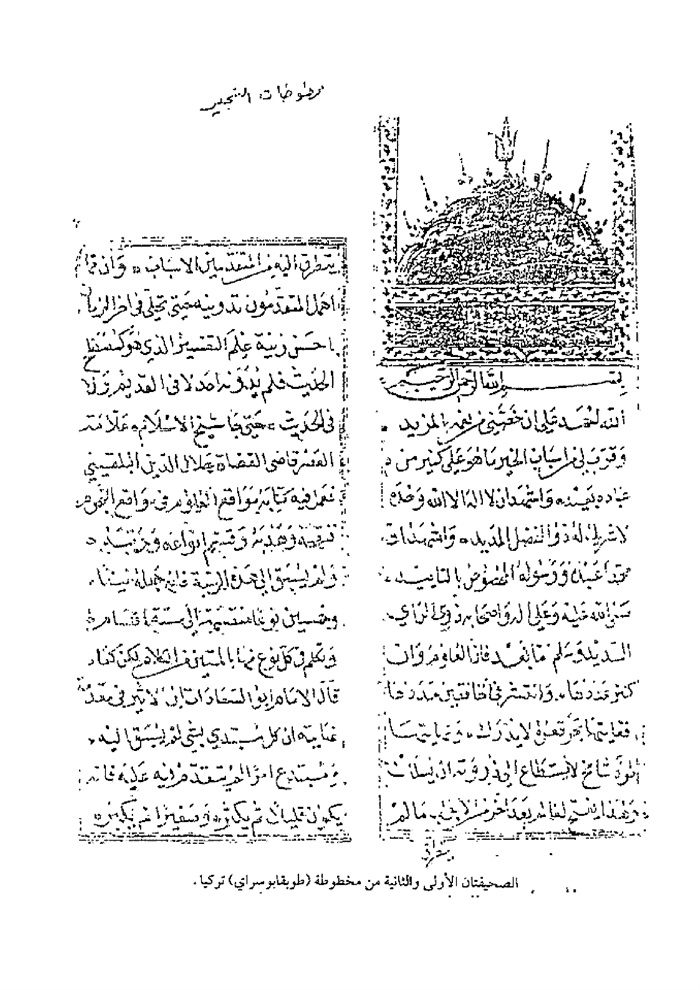
ص: 22
الصورة
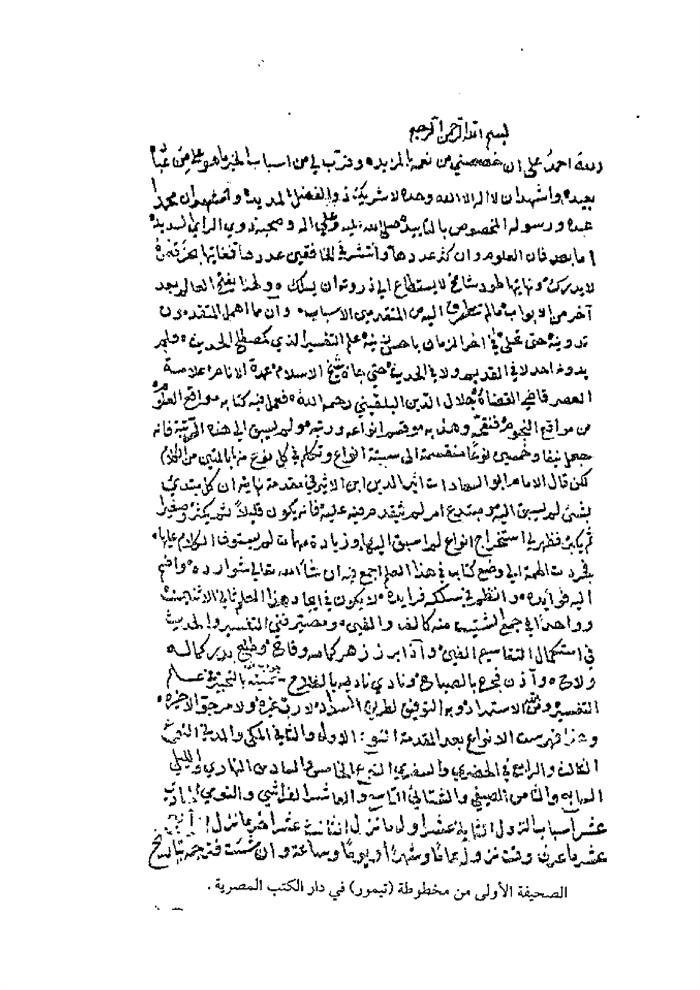
ص: 23
الصورة
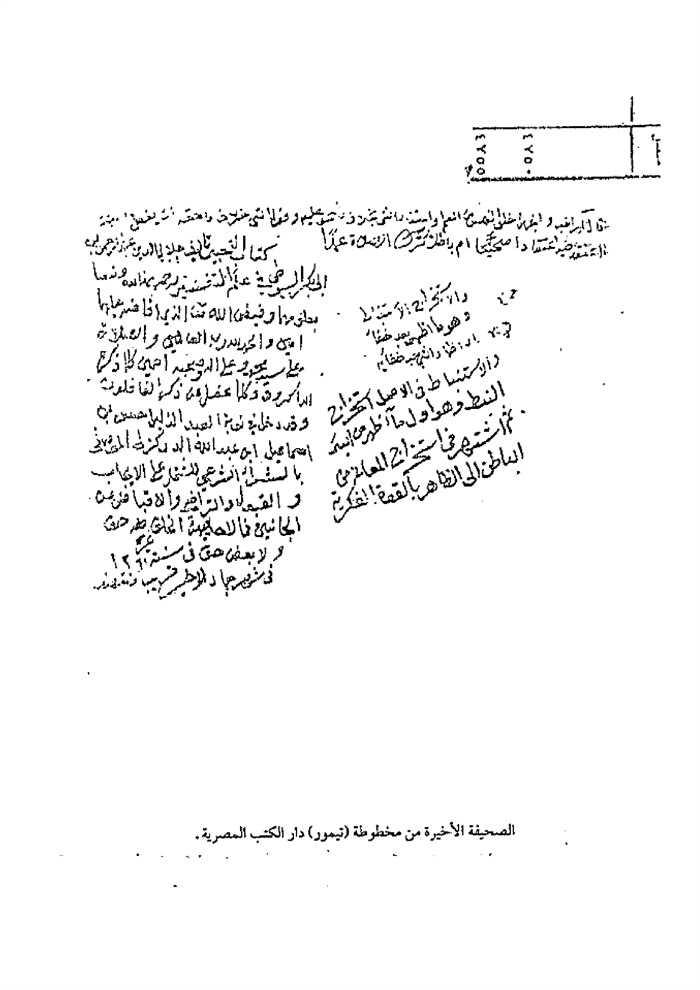
ص: 24
بسم اللّه الرحمن الرّحيم
اللّه أحمد على أن خصّني من نعمه بالمزيد، و قرّب لي من أسباب الخير ما هو على كثير من عباده بعيد، و أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ذو الفضل المديد، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله المخصوص بالتأييد، صلّى اللّه عليه و على آله و أصحابه ذوي الرأي السديد و سلّم. أما بعد:
فإن العلوم و إن كثر عددها، و انتشر في الخافقين مددها فغايتها بحر قعره لا يدرك، و نهايتها طود شامخ لا يستطاع إلى ذروته أن يسلك و لهذا يفتح لعالم بعد آخر من الأبواب ما لم يتطرّق إليه من المتقدّمين الأسباب.
و إن ممّا أهمل المتقدمون تدوينه حتى تحلّى في آخر الزّمان بأحسن زينة علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديث فلم يدوّنه أحد لا في القديم و لا في الحديث، حتى جاء شيخ الإسلام علامة العصر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني فعمل فيه كتابه «مواقع العلوم في مواقع النّجوم» فنقّحه و هذّبه و قسّم أنواعه و رتّبه، و لم يسبق إلى هذه الرتبة، فإنه جعله نيّفا و خمسين نوعا منقسمة إلى ستة أقسام، و تكلّم في كل نوع منها بالمتين من الكلام ليكن كما قال الإمام أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة نهايته: إن كلّ مبتدئ بشي ء لم يسبق إليه و مبتدع أمرا لم يتقدّم فيه عليه فإنه يكون قليلا ثم يكثر، و صغيرا ثم يكبر، فظهر لي استخراج أنواع لم يسبق إليها، و زيادة مهمّات لم يستوف الكلام عليها، فجرّدت الهمّة إلى وضع كتاب في هذا العلم أجمع فيه إن شاء اللّه شوارده، و أضمّ إليه فوائده، و أنظم في سلكه فرائده؛ لأكون في إيجاد هذا العلم ثاني اثنين، و واحدا في جمع الشّتيت منه كألف أو ألفين، و مصير فنّي التفسير و الحديث في استكمال التقاسيم إلفين، و إذا برز زهر كمامه و فاح و طلع بدر كماله و لاح و آذن فجره بالصّباح، و نادى داعيه بالفلاح سمّيته: بالتّحبير في علم التّفسير، و من اللّه الاستمداد، و به التّوفيق لطرق السّداد، لا ربّ غيره، و لا مرجوّ إلّا خيره و هذه فهرست الأنواع بعد المقدّمة:
ص: 25
النوع الأوّل و الثّاني: المكّيّ و المدنيّ.
الثالث و الرابع: الحضريّ و السّفري.
الخامس و السّادس: النّهاري و اللّيلي.
السابع و الثامن: الصّيفي و الشّتائي.
التاسع و العاشر: الفراشي و النّومي.
الحادي عشر: أسباب النّزول.
الثاني عشر: أوّل ما نزل.
الثالث عشر: آخر ما نزل.
الرابع عشر: ما عرف وقت نزوله عاما و شهرا و يوما و ساعة، و إن شئت فترجمه بتاريخ النّزول.
الخامس عشر: ما أنزل فيه و لم ينزل على أحد من الأنبياء.
السادس عشر: ما أنزل منه على الأنبياء قبل.
السّابع عشر: ما تكرّر نزوله.
الثامن عشر: ما نزل مفرّقا.
التاسع عشر: ما نزل جمعا.
العشرون: كيفيّة النّزول.
و هذه كلها متعلقة بالنزول و زوائدي منها ثمانية أنواع.
الحادي و العشرون: المتواتر.
الثاني و العشرون: الآحاد.
الثالث و العشرون: الشاذ.
الرابع و العشرون: قراءة النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم.
الخامس و العشرون و السّادس و العشرون: الرّواة و الحفّاظ.
السابع و العشرون: كيفيّة التحمّل.
ص: 26
الثامن و العشرون: العالي و النازل.
التاسع و العشرون: المسلسل.
و هذه الأنواع متعلقة بالسند، و زوائدي منها ثلاثة.
الثلاثون: الابتداء.
الحادي و الثلاثون: الوقف.
الثاني و الثلاثون: الإمالة.
الثالث و الثلاثون: المدّ.
الرابع و الثلاثون: تخفيف الهمزة.
الخامس و الثلاثون: الإدغام.
السادس و الثلاثون: الإخفاء.
السابع و الثلاثون: الإقلاب.
الثامن و الثلاثون: مخارج الحروف.
و هذه [الأنواع] متعلقة بالأداء و زوائدي منها ثلاثة.
التاسع و الثلاثون: الغريب.
الأربعون: المعرّب.
الحادي و الأربعون: المجاز.
الثاني و الأربعون: المشترك.
الثالث و الأربعون: المترادف.
و الرابع و الأربعون و الخامس و الأربعون: المحكم و المتشابه.
السادس و الأربعون: المشكل.
السابع و الأربعون: المجمل.
الثامن و الأربعون: المبيّن.
التاسع و الأربعون: الاستعارة.
ص: 27
الخمسون: التشبيه.
الحادي و الخمسون و الثاني و الخمسون: الكناية و التعريض.
و هذه الأنواع متعلقة بالألفاظ، و زوائدي منها خمسة:
الثالث و الخمسون: العامّ الباقي على عمومه.
الرّابع و الخمسون: العامّ المخصوص.
الخامس و الخمسون: العامّ الذي أريد به الخصوص.
السّادس و الخمسون: ما خصّ فيه الكتاب السنة.
السابع و الخمسون: ما خصّت فيه السّنّة الكتاب.
الثامن و الخمسون: المؤوّل.
التاسع و الخمسون: المفهوم.
الستون و الحادي و الستون: المطلق و المقيّد.
الثاني و الستون و الثالث و الستون: الناسخ و المنسوخ.
الرابع و الستون: ما عمل به واحد ثم نسخ.
الخامس و الستون: ما كان واجبا على واحد.
و هذه الأنواع متعلقة بالمعاني المتعلقة بالأحكام، و فيها من زوائدي واحد.
السادس و الستون، و السابع و الستون و الثامن و الستون: الإيجاز و الإطناب و المساواة.
التاسع و الستون: الأشباه.
السبعون و الحادي و السّبعون: الفصل و الوصل.
الثاني و السبعون: القصر.
الثالث و السبعون: الاحتباك.
الرابع و السبعون: القول بالموجب.
الخامس و السبعون و السادس و السبعون و السابع و السبعون: المطابقة، و المناسبة، و المجانسة.
الثامن و السبعون و التاسع و السبعون: التورية و الاستخدام.
الثمانون: اللّف و النشر.
ص: 28
الحادي و الثمانون: الالتفات.
الثاني و الثمانون: الفواصل و الغايات.
الثالث الثمانون و الرابع و الثمانون و الخامس و الثمانون: أفضل القرآن و فاضله و مفضوله.
السّادس و الثمانون: مفردات القرآن.
السّابع و الثمانون: الأمثال.
الثامن و الثمانون و التاسع و الثمانون: آداب القارئ و المقرئ.
التسعون: آداب المفسّر.
الحادي و التسعون: من يقبل تفسيره و من يردّ.
الثاني و التسعون: غرائب التفسير.
الثالث و التسعون: معرفة المفسّرين.
الرابع و التسعون: كتابة القرآن.
الخامس و التسعون: تسمية السّور.
السادس و التسعون: ترتيب الآي و السور.
السابع و التسعون و الثامن و التسعون و التاسع و التسعون: الأسماء و الكنى و الألقاب.
المائة: المبهمات.
الأول بعد المائة: أسماء من نزل فيهم القرآن.
الثاني بعد المائة: التّاريخ.
فهذه مائة نوع و نوعان، زوائدي منها خمسون نوعا، و ها أنا أشرع في بيانها مستعينا باللّه و متوكّلا عليه. و حبّذا ذاك اتكالا.
ص: 29
ص: 30
مأخوذ من الفسر و هو الكشف و الإظهار، و يقال: هو مقلوب السّفر تقول:
أسفر الصّبح إذا أضاء، و أسفرت المرأة عن وجهها النقاب كشفته، و قيل: مأخوذ من التّفسرة، و هي اسم لما يعرف به الطبيب المرض.
و أما في الاصطلاح فلهم فيه عبارات أحسنها قول أبي حيان: هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن و مدلولاتها و أحكامها الإفرادية و التركيبية و معانيها التي يحمل عليها حالة التركيب و تتمات لذلك.
[و قال هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراده بحسب الطاقة البشرية، و يتناول التفسير ما يتعلق بالرّواية، و التأويل، أي ما يتعلق بالدّراية] (1) قال فقولنا: علم جنس، و قولنا: يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، هو علم القراءة، و قولنا: و مدلولاتها، أي مدلولات تلك الألفاظ، و هذا متن علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم.
و قولنا: و أحكامها الإفرادية و التركيبية: هذا يشمل علم التصريف و البيان و البديع.
و قولنا: و معانيها التي يحمل عليها حالة التركيب يشمل ما دلالته بالحقيقة و ما دلالته بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا و يصدّ عن الحمل عليه صادّ فحمل على غيره و هو المجاز. و قولنا: و تتمات لذلك، هو مثل معرفة النسخ و سبب النزول و قصة توضّح بعض ما أبهم في القرآن و نحو ذلك.
و قال بعضهم: التفسير كشف معاني القرآن و بيان المراد منه سواء كانت معاني لغوية أو شرعية بالوضع أو بقرائن الأحول و معونة المقام.
و قال قوم التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلّا وجها واحدا، و التأويل توجيه لفظ يتوجّه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر عنده من الأدلة.
ص: 31
و قال الماتريدي: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا و الشهادة على اللّه أنه عنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح و إلّا فتفسير بالرأي و هو المنهيّ عنه، و التأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع و الشهادة على اللّه، و اختلف في جواز هذا، و سيأتي في باب من يقبل تفسيره.
، فوزنه فعلان كالغفران، و هو في اللغة الجمع.
و قال الجوهري: تقول قرأت الشي ء قرآنا إذا جمعته و ضممت بعضه إلى بعض قال أبو عبيدة: و سمّي القرآن لأنه يجمع السّور و يضمّها و يجمع العلوم الكثيرة و أنواع البلاغة، و قيل: مأخوذ من قرنت الشي ء بالشي ء، و أما في العرف فهو الكلام المنزّل على محمّد للإعجاز بسورة منه، فخرج بالمنزل على محمد التوراة و الإنجيل و سائر الكتب، و بالإعجاز الأحاديث الربّانيّة كحديث الصحيحين: «أنا عند ظنّ عبدي» إلى آخره و غيره، و الاقتصار على الإعجاز و إن أنزل القرآن لغيره أيضا لأنه المحتاج إليه في التمييز، و قولنا بسورة منه هو بيان لأقلّ ما وقع به الإعجاز و هو قدر أقصر سورة كالكوثر أو ثلاث آيات من غيرها بخلاف ما دونها، و زاد بعض المتأخرين في الحدّ «المتعبّد بتلاوته» ليخرج المنسوخ التلاوة.
اختلف في اشتقاقها فقيل: هي مأخوذة من سور البلد لارتفاعه سميت به لارتفاعها و شرفها، و قيل أصلها المنزلة الرفيعة، قال النابغة:
أ لم تر أن اللّه أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب
و قيل من سؤر الإناء أي بقيته لأنها جزء من القرآن، فعلى هذا أصلها الهمز فخفّفت، و حدّها بعضهم بأنها الطائفة المترجمة توقيفا، أي المسمّاة باسم خاص و الآية: أصلها: أاية كتمرة قلبت عينها ألفا على غير قياس، و قيل: آئية كقائلة، حذفت الهمزة تخفيفا، و قيل غير ذلك.
و هي في العرف: طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل و الفصل هو آخر الآية، و قد تكون كلمة مثل: و الفجر و الضّحى و العصر. و كذا الم. و طه. و يس. و نحوها عند الكوفيين و غيرهم لا يسميها آيات بل هي فواتح السور. و عن أبي عمرو الدّاني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلّا قوله: مُدْهامَّتانِ [ (55) الرحمن: 64].
و هما نوعان مهمّان إذ يعرف بذلك تأخير الناسخ عن المنسوخ، و اختلف الناس في
ص: 32
الاصطلاح فيهما، فالمشهور أن ما نزل قبل الهجرة مكي و ما بعدها مدني، سواء نزل بمكة أو المدينة أو غيرهما من الأسفار، و قيل: المكيّ ما نزل بمكة و لو بعد الهجرة، و المدنيّ:
ما نزل بالمدينة.
قلت: و على هذا القول ثبتت الواسطة قال البلقيني: و يؤيد الأول إجماعهم على أن المائدة مدنية مع أن فيها ما نزل بعرفات.
قلت: العجب منه أنه ادّعى هنا الإجماع ثم في آخر النوع استثنى منها النازل بعرفات و قال: إنه على الاصطلاح الثاني فأين الإجماع، ثم قال: و قيل المدني خمس و عشرون سورة: البقرة و ثلاث تليها، و الأنفال و براءة، و الرّعد، و الحج، خمس و عشرون سورة، و القتال، و الفتح، و الحجرات، و الحديد، و التحريم، و ما بينهما، و القيامة، و الزلزلة، و النصر، و من عدّها لم يذكر الفتح و هي سفرية، و المشهور أن القدر و المعوذتين مدنيتان و أن الرحمن و الإنسان و الإخلاص مكيّات، و قيل: الحج، و الحديد، و الصّفّ، و التغابن، و القيامة، و الزلزلة مكيّات.
و ذهب قوم إلى أن الفاتحة مدنية، و قال آخرون: نزلت مرتين، و قال بعضهم: نزل نصفها بمكة، و نصفها بالمدينة، و قال أبو الحسن الحصّار في كتابه الناسخ و المنسوخ:
المدني عشرون سورة و نظمها مع السور المختلف فيها في أبيات فقال:
يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا *** وعن ترتّب ما يتلى من السّور
وكيف جاء بها المختار من مضر *** صلى الإله على المختار من مضر
وما تقدّم منها قبل هجرته *** وما تأخّر في بدو وفي حضر
ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد *** يؤيّد الحكم بالتاريخ والنظر
تعارض النقل في أمّ الكتاب وقد *** تولّت الحجر تنبيها لمعتبر
أمّ القرآن وفي أمّ القرى نزلت *** ما كان للخمس قبل الحمد من أثر
لو كان ذاك لكان النّسخ أولها *** ولم يقل بصريح النّسخ من بشر
وبعد هجرة خير النّاس قد نزلت *** عشرون من سور القرآن في عشر
فأربع من طوال السبع أوّلها *** وخامس الخمس في الأنفال ذي العبر
وتوبة الله إن عددت سادسة *** وسورة النّور والأحزاب ذي الذكر
وسورة لنبيّ الله محكمة *** والفتح والحجرات الغرّ في غرر
ص: 33
ثم الحديد ويتلوها مجادلة *** والحشر ثم امتحان الله للبشر
وسورة فضح الله النفاق بها *** وسورة الجمع تذكارا لمذّكر
وللطّلاق وللتحريم حكمهما *** والنّصر والفتح تنبيها على العمر
هذا الذي اتفقت فيه الرواة له *** وقد تعارضت الأخبار في أخر
فالرّعد مختلف فيها متى نزلت *** وأكثر الناس قالوا الرّعد كالقمر
ومثلها سورة الرحمن شاهدها *** مما تضمّن قول الجنّ في الخبر
وسورة للحواريّين قد علمت *** ثم التغابن والتطفيف ذو النّذر
وليلة القدر قد خصّت بملّتنا *** ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبر
وقل هو الله أوصاف خالقنا *** وعوذتان تردّ البأس بالقدر
وذا الذي اختلفت فيه الرواة له *** وربّما استثنيت آي من السّور
وما سوى ذاك مكّيّ تنزّله *** فلا تكن من خلاف الناس في حصر
فليس كلّ خلاف جاء معتبرا *** إلّا خلافا له حظّ من النّظر
و قد روينا من طرق عن الصحابة و التابعين عدّ المكّيّ و المدنيّ فقال البيهقي في دلائل النبوة: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد العدل. حدّثنا محمد ابن إسحاق حدّثنا يعقوب بن إسحاق الدّورقي. حدّثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي.
حدّثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه، حدثني يزيد النحوي عن عكرمة و الحسين ابن أبي الحسين، قالا: ما أنزل اللّه من القرآن بمكة: اقرأ باسم ربّك، و نون، و المزمّل، و المدّثّر، و تبّت يدا أبي لهب، و إذا الشّمس كورت، و سبّح اسم ربّك الأعلى، و اللّيل إذا يغشى، و الفجر، و الضّحى، و أ لم نشرح، و العصر، و العاديات، و الكوثر، و ألهاكم، و أ رأيت، و قل يأيّها الكافرون، و أصحاب الفيل، و الفلق، و قل أعوذ برب الناس، و قل هو اللّه أحد، و النّجم، و عبس، و إنّا أنزلناه، و الشّمس و ضحاها، و السماء ذات البروج، و التين، و لإيلاف قريش، و القارعة، و لا أقسم بيوم القيامة، و الهمزة، و المرسلات، و ق، و لا أقسم بهذا البلد، و الطّارق، و اقتربت السّاعة، و ص، و الجنّ، و يس، و الفرقان، و الملائكة، و طه، و الواقعة، و طسم، و طس، و طسم، و بني إسرائيل، و السّابعة، و يوسف، و هود، و أصحاب الحجر، و الأنعام، و الصّافّات، و لقمان، و سبأ، و الزّمر، و حم المؤمن، و حم الدخان، و حم السّجدة و حم عسق، و حم الزّخرف، و الجاثية، و الأحقاف، و الذّاريات، و الغاشية، و أصحاب الكهف، و النّحل، و نوح، و إبراهيم، و الأنبياء، و المؤمنون، و الم السجدة، و الطّور، و تبارك، و الحاقّة، و سأل، و عمّ
ص: 34
يتساءلون، و النّازعات، و إذا السّماء انشقّت، و إذا السماء انفطرت، و الرّوم، و العنكبوت.
و ما نزل بالمدينة: ويل للمطففين، و البقرة، و آل عمران، و الأنفال و الأحزاب.
و المائدة، و الممتحنة، و النساء، و إذا زلزلت، و الحديد، و محمّد، و الرّعد، و الرّحمن، و هل أتى على الإنسان، و الطّلاق، و لم يكن، و الحشر، و إذا جاء نصر اللّه، و النّور، و الحجّ، و المنافقون، و المجادلة، و الحجرات، و يأيّها النّبيّ لم تحرم، و الصّف، و الجمعة، و التّغابن، و الفتح، و براءة. قال البيهقي: و السّابعة يريد بها سورة يونس، قال:
و قد سقط من هذه الرواية: الفاتحة، و الأعراف، و كهيعص ممّا نزل بمكة.
قال: و قد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد ابن الفضل، حدّثنا إسماعيل بن عبد اللّه بن زرارة الرّقي حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشيّ خصيف عن مجاهد ابن عباس أنه قال: إنّ أول ما أنزل اللّه على نبيه من القرآن:
اقرأ باسم ربك، فذكر معنى هذا الحديث و ذكر السّور التي سقطت من الرواية الأولى في ذكر ما نزل بمكة. قال: و للحديث شاهد في تفسير مقاتل و غيره مع المرسل الصحيح الذي تقدم. قلت: و سيأتي مثله في أول ما نزل.
و قال أبو بكر بن الأنباري: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدّثنا حجّاج بن منهال حدّثنا همام عن قتادة قال: نزل في المدينة من القرآن: البقرة، و آل عمران، و النساء (1)، و المجادلة، و الحشر، و الممتحنة، و الصّفّ، و الجمعة، و المنافقون، و التغابن، و الطلاق، و يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ إلى رأس العشر من الآي، و إِذا زُلْزِلَتِ و إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ و سائر القرآن نزل بمكة.
و في الصحيح عن عائشة رضي اللّه عنها: ما نزلت سورة البقرة و النساء إلا و أنا عنده.
و قال أبو عبيد في فضائل القرآن: حدّثنا عبد اللّه بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة قال: نزلت بالمدينة: سورة البقرة، و آل عمران، و النساء، و المائدة، و الأنفال، و التوبة، و الحجّ، و النّور، و الأحزاب، و الّذين كفروا، و الفتح، و الحديد، و المجادلة، و الحشر، و الممتحنة، و الحواريّون- يريد الصّفّ- و التغابن و يأيّها النبي إذا طلّقتم النّساء، و يأيّها النّبيّ لم تحرّم، و اللّيل، و إنّا أنزلناه في ليلة القدر، و لم يكن، و إذا زلزلت، و إذا جاء نصر اللّه، و سائر ذلك بمكة.
ص: 35
و قد توافقت الأقوال التي حكيناها على أن سورة يونس مكّية، و فيها أيضا قولان، فروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق خصيف عن مجاهد عن عبد اللّه بن الزبير أنها مكية، و روي مثله من طريق عطاء و غيره عن ابن عباس ثم روي من طريق عطاء عنه أنها أنزلت بالمدينة و اللّه تعالى أعلم.
و قد ظهر لي بالنظر في الأدلة النقلية ما يرجّح بعض الأقوال في السور المختلف فيها فمن ذلك: الحديد، فالمختار أنها مكّية، ففي مسند البزار و غيره عن عمر قال: كنت أشدّ الناس على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فذكر الحديث في إسلام أخته و مجيئه لها مغضبا و جلوسه في بيتها على السرير قال: فإذا عليه صحيفة فقلت: ما هذه الصحيفة؟ فقالت: دع هذا فإنه لا يمسّه إلّا المطهّرون، و أنت لا تطهر من الجنابة، قال: فما زلت بها حتى ناولتني إياها فإذا فيها: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ حتى بلغ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. الحديث.
و إسلام عمر قديما قبل الهجرة بدهر مديد. و روى الحاكم عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامهم و بين نزول هذه الآية يعاتبهم اللّه بها إلّا أربع سنين وَ لا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ [ (57) الحديد: 10].
فظاهره أنه قبل الهجرة بست سنين أو أكثر على الخلاف في مدة إقامته صلّى اللّه عليه و سلّم بمكة بعد البعثة، و من ذلك: الكوثر و المختار أنها مدنية لحديث أنس في نزولها الآتي في النومي، و أنس لم يكن بمكة و إنما كان بالمدينة. و من ذلك الصّف، و المختار أنها مدنية أيضا لحديث عبد اللّه بن سلام في نزولها الآتي أيضا و هو إنما كان بالمدينة. و من ذلك:
المعوّذتان و المختار أنهما مدنيتان، و أما الفاتحة فالمختار فيها قول الجمهور، و لكن روى الطبراني في الأوسط قال: حدّثنا عبيد بن غنّام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة أن إبليس رنّ حين أنزلت فاتحة الكتاب و أنزلت بالمدينة. هذا إسناد رجاله رجال الصحيح، و قد كان خطر لي في القدح فيه أن الجملة الأخيرة منه مدرجة في الحديث و ليست منه، ثم رأيت أبا عبيد أخرجها من قول مجاهد فقال: حدّثنا عبد الرحمن بن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة، و أخرجها عنه أيضا الفريابي في تفسيره، و أخرج مقاتل في تفسيره الجملة الأولى عنه أيضا فصار علة للحديث المرفوع.
ضابط: روى البيهقي في الدلائل و البزّار في مسنده من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه قال: ما كان: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنزل بالمدينة، و ما
ص: 36
كان: يا أَيُّهَا النَّاسُ فبمكة، قال ابن عطية: هو في: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صحيح، و أما: يا أَيُّهَا النَّاسُ فقد يأتي في المدنيّ، و قال ابن الحصّار: قد اعتني المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث و اعتمدوه على ضعفه، و قد اتفق الناس على أن النساء مدنيّة و أولها:
يا أَيُّهَا النَّاسُ، و على أن الحج مكيّة و فيها: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا [ (22) الحج: 77].
و قد روى أبو عبيد هذا عن علقمة مرسلا، و روي عن علي بن معبد عن أبي مليح عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن يا أَيُّهَا النَّاسُ أو يا بَنِي آدَمَ فإنه مكّيّ، و ما كان يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فإنّه مدني.
و قال البيهقي في الدلائل من طريق يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
كلّ شي ء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم و القرون فإنّما نزل بمكّة و ما كان من الفرائض و السنن فإنّما نزل بالمدينة، و سيأتي عن عائشة نحوه.
قال البيهقي: في بعض السّور التي نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة فألحقت بها، و كذا قال ابن الحصّار: كلّ نوع من المكّيّ و المدنيّ منه آيات مستثناة، قال: إلّا أنّ من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النّقل انتهى.
و ها أنا أذكر منه أمثلة حرّرتها بعد الفحص الشديد:
الأول: قال البلقيني: استثني من البقرة آيتان: فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا [ (2) البقرة: 19].
لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ [ (2) البقرة: 110].
و على الاصطلاح الثاني ثلاث أخر: وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ [ (2) البقرة: 281] آمَنَ الرَّسُولُ [ (2) البقرة: 295] الآيتين فإنهما سفريتان.
قلت: فإن عملنا بما تقدّم عن ابن مسعود استثني قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ [ (2) البقرة: 21، 25]، و كذا ما بعدها إلى قوله: خالدون، فإنها مشتبكة بها في المعنى الثاني، قال أيضا: استثني من النساء على الاصطلاح الثاني: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها [ (4) النساء: 58] و آية الكلالة.
الثلاث: من المائدة الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [ (5) المائدة: 3] عليه أيضا.
الرابع: قال ابن الحصّار: استثنى بعضهم من الأنعام تسع آيات و لا يصح به نقل
ص: 37
خصوصا أنه ورد أنّها نزلت جملة واحدة، و الآيات المذكورة: قُلْ تَعالَوْا [ (6) الأنعام:
151، 152، 153] الآيات الثلاث- وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ [ (6) الأنعام: 91، 92، 93]. الآيات الثلاث.
الخامس: قال البلقيني: استثني من الأنفال أولها، و يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ [ (8) الأنفال: 64] و هما على الاصطلاح الثاني.
قلت: فيه نظر من وجوه: أحدهما: أن أولها كما أنه لم ينزل بالمدينة لم ينزل بمكة بل ببدر فهو ليس بمكّي، ثانيها نزل ببدر أيضا غير أولها كما سيأتي في السفري، ثالثها الآية الثانية على الاصطلاح الأول فقد روى البزار من طريق النضر عن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر رضي اللّه عنه.
السادس: من هود وَ أَقِمِ الصَّلاةَ [ (11) هود: 114] و قيل: فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ.
السابع: من الرّعد وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً [ (13) الرعد: 31]، وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا [ (13) الرعد: 7] فمدنيتان، و قيل لا، و المدني منها: وَ لا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا [ (13) الرعد: 31]، و قيل: بل قوله: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً [ (13) الرعد: 12، 13] إلى قوله:
شَدِيدُ الْمِحالِ [الرعد: 12- 13] فإنها نزلت في عامر بن الطفيل و أربد بن قيس لمّا قدما المدنية في وفد بني عامر كما رواه الطبراني في الأوسط.
الثامن: ينبغي أن يستثنى من الحجر: وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ [ (15) الحجر: 24] الآية، ففي الترمذي من حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلّي خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم حينا فكان بعض القوم يتقدّم حتّى يكون في الصّف الأوّل لأن لا يراها، و يتأخّر بعضهم حتّى يكون في الصّفّ المؤخّر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل اللّه هذه الآية.
التّاسع: من النحل: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ [ (16) النحل: 126] إلى آخر السورة فهو نازل بعد الهجرة و سيأتي مكان نزوله، و قال ابن الحصّار: الصحيح عندي أنها كلها مكية، و أن آخرها نزل مرة ثانية في أحد و الفتح تذكيرا من اللّه لعباده، و استثنى منها قتادة: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا [ (16) النحل: 110] إلى آخر السورة. و قال بعضهم: بل أربعون آية منها مكّي و الباقي مدني و سيأتي في أول ما نزل.
العاشر: استثنى بعضهم من الإسراء: وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ [ (17) الإسراء: 73، 80] الآيات الثمان، و بعضهم: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ [ (17) الإسراء: 85].
ص: 38
لما روى البخاريّ عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلّى اللّه عليه و سلّم بالمدينة و هو يتوكّأ على عسيب فمرّ بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه، فقالوا: حدّثنا عن الرّوح فقام النبي صلّى اللّه عليه و سلّم ساعة و رفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: «الرّوح من أمر ربي و ما أوتيتم من العلم إلّا قليلا» قال ابن كثير: و قد تكون نزلت عليه هذه الآية مرة ثانية بعد نزولها بمكة فإن السورة كلها مكية- و استثنى بعضهم أيضا: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ [ (17) الإسراء: 88]، فقد روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنها نزلت في نفر من اليهود قالوا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به.
الحادي عشر: من الحج على قول إنها مكّية: الآيات السفرية و ستأتي، و على قول إنها مدنية: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إلى عَقِيمٍ [ (22) الحج: 52، 55] فهو مكي.
الثاني عشر: من الشعراء وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ [ (26) الشعراء: 224، 227] إلى آخر السورة فهو مدني قاله مكي.
الثالث عشر: من الرّوم أوّلها فقد نزل ببدر كما رواه الترمذي عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الرّوم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت: الم غُلِبَتِ الرُّومُ إلى قوله: بِنَصْرِ اللَّهِ [ (30) الروم: 1، 5].
لكن روي أيضا عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت: الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. خرج أبو بكر الصّديق يصيح بها في نواحي مكة. الحديث، و قال: حسن صحيح. قال ابن الحصّار و هو أصحّ من الأول. و قد يتكرر نزول الآية تذكارا و موعظة انتهى.
الرّابع عشر: من السّجدة أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً [ (32) السجدة: 18، 20] الآيات الثلاث.
الخامس عشر: من سورة سبأ الآيات التي فيها ذكر سبأ، فقد روى الترمذي عن فروة ابن مسيك المرادي قال: أتيت النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فقلت: يا رسول اللّه: أ لا أقاتل من أدبر من قومي الحديث، و فيه و أنزل في سبأ ما أنزل فقال رجل: يا رسول اللّه و ما سبأ إلى آخره. قال ابن الحصّار: و مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع قال: و يحتمل أن يكون قوله: و أنزل حكاية عما تقدّم نزوله قبل هجرته.
السادس عشر: من يس: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى [ (36) يس: 12] الآية.
ص: 39
فقد روى الترمذي و الحاكم في المستدرك و البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان بنو سلمة في نواحي المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل اللّه: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ .. فدعاهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: «إنه يكتب آثاركم و قرأ عليهم الآية فتركوا»، و الحديث في الصحيح عن أنس بدون ذكر هذه الآية.
السّابع عشر: من الزّمر قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا [ (39) الزمر: 53] الآيات الثلاث، ففي المستدرك من حديث نافع عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنه قال: كنا نقول:
ما لمفتتن توبة و ما اللّه بقابل منه شيئا، فلمّا قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم المدينة أنزل فيهم قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ .. و الآيات التي بعدها، و استثنى أيضا: وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ [ (39) الزمر: 67] الآية لما، روى الترمذي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال:
مرّ يهودي بالنبي صلّى اللّه عليه و سلّم فقال له النبي: «يا يهودي حدّثنا» فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع اللّه السماوات على ذه و الأرضين على ذه و الماء على ذه و الجبال على ذه و سائر الخلق على ذه فأنزل اللّه: وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ .. و قال حسن صحيح لكنه في الصحيحين بلفظ «فتلا الآية» و لم يقل: فأنزل.
الثامن عشر: من الحديد على ما اخترته من أنها مكية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ [ (57) الحديد: 28، 29] إلى آخر السورة فهو مدني نزل بعد أحد في أربعين من الحبشة كما رواه الطبراني في الأوسط.
التاسع عشر: من التغابن على قول إنها مكّية ما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: نزلت هذه الآية: إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ في قوم من أهل مكة أسلموا فأبى أزواجهم و أولادهم أن يدعوهم، فأتوا المدينة فلما قدموا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم رأوا الناس قد فقهوا فهمّوا أن يعاقبوهم فأنزل اللّه: وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا، فهذه أمثلة حررتها نقلا و دليلا و ما أحب أن لي بتحريرها الدنيا و ما فيها.
روى الطبراني في الكبير من طريق الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة، و المدينة، و الشام». قال الوليد: يعني بيت المقدس، قال ابن كثير: بل تفسيره بتبوك أحسن.
ص: 40
الأول كثير و للثاني أمثلة ذكر البلقيني منها قليلا.
أحدها: و هو مما لم يذكره فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ [ (2) البقرة: 196].
ففي الصحيح من حديث كعب بن عجرة قال: كنّا مع النبي صلّى اللّه عليه و سلّم بالحديبية و نحن محرمون و كانت لي وفرة فجعلت الهوامّ تتساقط على وجهي فمرّ بي النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فقال:
«أ يؤذيك هوامّ رأسك؟» فقلت: نعم فأنزلت هذه الآية.
ثانيها: وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ [ (2) البقرة: 281] نزلت بمنى فيما رواه البيهقي في الدلائل.
ثالثها: آمَنَ الرَّسُولُ [ (2) البقرة: 285] إلى آخر السورة، قيل: نزلت يوم فتح مكة.
رابعها: و لم يذكره البلقيني لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ [ (3) آل عمران: 128] نزلت بأحد، فروى الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يوم أحد: «اللهمّ العن أبا سفيان، اللهمّ العن الحارث بن هشام، اللهم العن صفوان بن أميّة»، فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ... و في الصحيح أن ذلك كان في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح.
خامسها: و لم يذكره وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ [ (3) آل عمران: 144] الآية نزلت بأحد، فقد روى البيهقي في الدلائل من طريق آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار و هو يتشحّط في دمه فقال له: أشعرت أن محمّدا قد قتل؟ فقال: إن كان محمد قد قتل فقد بلّغ، فقاتلوا عن دينكم فنزلت.
سادسها: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها [ (4) النساء: 58] نزلت يوم الفتح في شأن مفتاح الكعبة.
سابعها: آية الكلالة نزلت بين مكة و المدينة مرجعه صلّى اللّه عليه و سلّم من حجة الوداع.
ثامنها: و لم يذكره، أوّل المائدة، ففي شعب الإيمان من طريق سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة المائدة على النبي صلّى اللّه عليه و سلّم بمنى إن كادت من ثقلها لتكسر عظام النّاقة.
و في الدلائل من حديث عاصم الأحول عن أم عمرو بنت عيسى عن عمها: كان النبي صلّى اللّه عليه و سلّم في مسير فنزلت عليه سورة المائدة فاندقّت كتف راحلته العضباء من ثقل السورة.
ص: 41
و روى أبو عبيد عن عمر بن طارق عن يحيى بن أيوب عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي قال: نزلت سورة المائدة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم في حجّة الوداع فيما بين مكة و المدينة و هو على ناقته فانصدع كتفها فنزل عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم.
تاسعها: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [ (5) المائدة: 3] ففي الصّحيح من حديث عمر أنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع.
عاشرها: آية التّيمّم، ففيه من حديث عائشة أنها نزلت بالبيداء أو بذات الجيش قرب المدينة في القفول من غزوة المريسيع.
حادي عشرها: أوّل الأنفال، فقد روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير و قتلت سعيد بن العاص و أخذت سيفه فأتيت به النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فقال:
«اذهب فاطرحه، فرجعت و بي ما لا يعلمه إلّا اللّه من قتل أخي و أخذ سلبي»، قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «اذهب فخذ سيفك».
ثاني عشرها: و لم يذكره: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ [ (8) الأنفال: 9]، ففي الصحيح عن عمر قال: نظر النبي صلّى اللّه عليه و سلّم إلى المشركين و هو ألف و أصحابه ثلاثمائة و بضعة عشر فاستقبل القبلة، و جعل يهتف بربه فأنزل اللّه هذه الآية.
ثالث عشرها: و لم يذكره: وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ [ (8) الأنفال: 16] روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت يوم بدر.
رابع عشرها: آيات من أثناء براءة في غزوة تبوك.
خامس عشرها: و لم يذكره: ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ الآيتين [ (9) التوبة: 113، 114] فقد روى الطّبرانيّ في الكبير عن ابن عباس أنه صلّى اللّه عليه و سلّم لما أقبل من غزوة و اعتمر، فلمّا هبط من ثنيّة عسفان نزل على قبر أمه و بكى و دعا اللّه أن يأذن له في الشفاعة لها فنزل جبريل بهاتين الآيتين.
سادس عشرها: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا ... إلى آخر السورة. فأخرج البيهقي في الدلائل و البزار في مسنده من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم وقف على حمزة حين استشهد و قد مثل به، فذكر الحديث إلى أن قال لأمثّلنّ بسبعين منهم مكانك فنزل جبريل و النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم واقف بخواتيم سورة النّحل وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ إلى آخر السورة، فهو صريح في نزولها بأحد، و عزى البلقيني هذا الحديث إلى الغيلانيات و هو قصور.
ص: 42
و أخرج الترمذي من حديث أبيّ بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة و ستون رجلا و من المهاجرين ستّة منهم حمزة فمثّلوا بهم فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم قال: فلمّا كان يوم الفتح أنزل اللّه: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ قال التّرمذيّ: حسن غريب، قال البلقيني: و قد يقال لا معارضة بين الحديثين لأن أعمال هذا الصبر إنما وقع يوم فتح مكة.
قلت: المعارضة واقعة بين قوله نزلت و النبي واقف على حمزة و وقوفه بأحد، و قوله: فلمّا كان يوم فتح مكة أنزل اللّه، و أيّ جمع حصل من كلامه المذكور؟ و إنما يجمع بما تقدّم عن ابن الحصّار أنها نزلت أولا بمكة ثمّ ثانيا بأحد ثمّ ثالثا يوم الفتح تذكيرا من اللّه لعباده.
سابع عشرها: و لم يذكره أول الحج، ففي التّرمذيّ عن عمران بن حصين قال:
أنزلت على النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ ءٌ عَظِيمٌ إلى قوله:
وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ و هو في سفر فقال: أ تدرون أيّ يوم ذلك؟ الحديث. و في المستدرك عن أنس مثله.
ثامن عشرها: هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا إلى قوله: الْحَمِيدِ [ (22) الحج: 19، 25] ففي البخاريّ عن أبي ذر أنّه كان يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة و صاحبيه، و عتبة و صاحبيه.
قال البلقيني: فالظاهر أنها نزلت يوم بدر وقت المبارزة لما فيه من الإشارة بهذين.
تاسع عشرها: و لم يذكره أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا الآية [ (22) الحج: 39] ففي المستدرك عن ابن عباس: لما أخرج أهل مكة النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قال أبو بكر: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون أخرجوا نبيّهم ليهلكن فنزلت هذه الآية.
قال ابن الحصّار: استنبط بعضهم من هذا الحديث أنها نزلت في سفر الهجرة.
العشرون: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ [ (28) القصص: 85] قيل: نزلت بالجحفة في سفر الهجرة.
الحادي و العشرون: أوّل الرّوم كما تقدّم.
الثّاني و العشرون: سورة الفتح بجملتها، كذا قال البلقيني و تمسّك بظاهر ما رواه البخاريّ من حديث عمر: بينما هو يسير مع النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم فذكر الحديث و فيه: فقال رسول اللّه
ص: 43
صلّى اللّه عليه و سلّم: «لقد أنزلت عليّ الليلة سورة هي أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشّمس» فقرأ: إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ و لا دليل فيه على نزولها تلك الليلة، بل النّازل فيها أوّلها و قد وردت أحاديث بنزول سورة الفتح بين مكة و المدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها (1).
لطيفة: ورد تبيين الموضع الذي نزلت فيه و هو كراع الغميم رواه الحاكم أيضا.
الثّالث و العشرون: و لم يذكره سورة المنافقون، فقد روى الترمذي من طريق إسرائيل عن السّدّيّ عن أبي سعيد الأزديّ قال: أخبرنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و كان معنا ناس من الأعراب، فسبق أعرابيّ فملأ الحوض، فأتى رجل من الأنصار أعرابيّا فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه و رفع الأعرابيّ خشبة فضرب بها رأس الأنصاريّ فشجّه، فأتى عبد اللّه بن أبيّ رأس المنافقين فأخبره و كان من أصحابه فغضب و قال: لا تنفقوا على من عند رسول اللّه حتّى ينفضّوا ثم قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ فأخبرت عمّي فأخبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فحلف (2) و جحد قال:
فصدّقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و كذّبني فجاء عمّي فقال: ما أردت إلى أن مقتك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و كذّبك فوقع عليّ من الهمّ ما لم يقع على أحد، فبينا أنا أسير مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم في سفر قد خفقت رأسي من الهمّ إذ أتاني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فعرك أذني و ضحك في وجهي فلحقني أبو بكر فقال: ما قال لك رسول اللّه؟ قلت: ما قال شيئا إلا أنّه عرك أذني و ضحك في وجهي فقال: أبشر ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر فلما أصبحنا قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم سورة المنافقين قال الترمذي: حسن صحيح.
ففي هذا الحديث مع كونها نزلت بالسفر ما يقتضي أنها نزلت بالليل. ثم روي أيضا من حديثه أن ذلك في غزوة تبوك، و من حديث جابر بن عبد اللّه نحو ذلك، و فيه قال سفيان: يروون أنها نزلت في غزوة بني المصطلق و قال في كل من الحديثين حسن صحيح، و هو في الصحيحين بدون قول سفيان و ذكر ابن إسحاق أيضا أنها نزلت في غزوة بني المصطلق.
ص: 44
الرّابع و العشرون: سورة النّصر، روى البيهقي و البزّار عن ابن عمر أنها نزلت أواسط أيام التشريق عام حجة الوداع.
الأوّل: كثير و للثاني أمثلة لم يستوفها البلقيني.
أحدها: آية القبلة ففي الصّحيحين: بينما النّاس بقباء في صلاة الصّبح إذ أتاهم آت فقال: إن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قد أنزل عليه الليلة قرآن.
ثانيها: و لم أر من ذكره، خواتيم سورة البقرة، ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود:
لما أسري برسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم انتهى إلى سدرة المنتهي. الحديث و فيه فأعطي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم منها ثلاثا: أعطي الصّلوات الخمس، و أعطي خواتيم سورة البقرة و غفر لمن لا يشرك باللّه من أمته شيئا من المقحمات، و قد أعطي الصّلوات ليلة الإسراء فالظاهر أنه أعطي الأخرى ليلتئذ. لكن الأحاديث في الصحيح في بيان نزولها عن ابن عباس رضي اللّه عنه و غيره يخالف هذا و يجمع بين ذلك بأنها نزلت بعد إعطائه إياها ليلة الإسراء.
ثالثها: وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [ (5) المائدة: 67]، فقد روى الحاكم و الترمذي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان النبي صلّى اللّه عليه و سلّم يحرس حتى نزلت هذه الآية: وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فأخرج رأسه من القبّة فقال لهم: «يا أيّها النّاس انصرفوا فقد عصمني اللّه»، و هذه الآية مثال للفراشي أيضا.
رابعها: سورة الأنعام بكمالها فقد روى أبو عبيد قال: حدّثنا حجاج عن حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة.
خامسها: آية الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا [ (9) التوبة: 118] ففي الصّحيح من حديث كعب فأنزل اللّه توبتنا حين بقي الثّلث الأخير من الليل و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم عند أمّ سلمة.
سادسها: روى التّرمذيّ من حديث أنس أن هذه الآية: تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ [ (32) السجدة: 16] نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، و قال: حسن صحيح، فظاهره أنها نزلت في ذلك الوقت.
سابعها: آية الإذن في خروج النسوة في الأحزاب، قال البلقيني: و الظاهر أنها: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ [ (33) الأحزاب: 59].
ص: 45
ففي البخاريّ عن عائشة رضي اللّه عنها خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها و كانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال: يا سودة أما و اللّه ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأت راجعة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و إنه ليتعشّى و في يده عرق فقلت: يا رسول اللّه خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا و كذا فأوحى اللّه إليه و إن العرق في يده ما وضعه فقال: «إنّه قد أذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكنّ».
قال البلقيني: و إنما قال إن ذلك كان ليلا لأنهم إنما كنّ يخرجن للحاجة ليلا كما في الصحيح عن عائشة في حديث الإفك.
ثامنها: سورة الفتح كما تقدّم و بيّنا أنها لم تنزل كلها ليلا، و في بعض الأحاديث أنها إلى: صِراطاً مُسْتَقِيماً.
تاسعها: سورة المنافقون كما تقدّم.
و منه ما نزل بين اللّيل و النهار في وقت الصبح و يصلح أن يجعل نوعا مستقلا، و يحضرني منه مثالان:
الأوّل: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ [ (3) آل عمران: 128] فقد تقدّم أنها نزلت و هو في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح.
الثّاني: آية من الفتح، فقد روى مسلم و الترمذي و غيرهما عن أنس أن ثمانين هبطوا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و أصحابه من جبل التّنعيم عند صلاة الصّبح يريدون أن يقتلوه فأخذوا أخذا فأعتقهم فأنزل اللّه: وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ [ (48) الفتح: 24].
الأول له أمثلة.
أحدها: و لم يذكر البلقيني غيره: آية الكلالة، ففي صحيح مسلم عن عمر: ما راجعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم في شي ء ما راجعته في الكلالة، و ما أغلظ لي في شي ء ما أغلظ لي فيه حتّى طعن بإصبعه في صدري و قال: «يا عمر ألا يكفيك آية الصّيف التي في آخر سورة النّساء».
و أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول اللّه ما الكلالة؟
ص: 46
قال: أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [ (4) النساء:
176] قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، قلت: و قد تقدّم أن ذلك في سفر حجة الوداع.
ثانيها و ثالثها و رابعها: وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ [ (2) البقرة: 281] و أول المائدة، و الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [ (5) المائدة: 3] لأن ذلك مما نزل بحجّة الوداع فهو قريب الزّمن من آية الكلالة.
خامسها: غالب آيات غزوة تبوك في براءة فقد كانت في شدّة الحر كما في الحديث و نصّ اللّه تعالى في كتابه فقال: وَ قالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ [ (9) التوبة: 81].
و قد قال البيهقي في الدّلائل: أخبرنا أبو عبد اللّه حدثنا أبو العبّاس حدثنا أحمد حدّثنا يونس عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة و عبد اللّه بن أبي بكر بن حزم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ما كان يخرج في وجه من مغازيه إلّا أظهر أنّه يريد غيره، غير أنه في غزوة تبوك قال: «يا أيّها النّاس، إنّي أريد الرّوم» فأعلمهم و ذلك في زمن البأس و شدّة من الحرّ و جدب البلاد، فبينما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ذات يوم في جهازه إذ قال للجدّ بن قيس: «يا جدّ هل لك في بنات بني الأصفر»؟ قال: يا رسول اللّه لقد علم قومي أنّه ليس أحد أشدّ عجبا بالنّساء منّي و إني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر أن يفتنّني فأذن لي، فأنزل اللّه وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَ لا تَفْتِنِّي [ (9) التوبة: 49]، و قال رجل من المنافقين: لا تنفروا في الحرّ فأنزل اللّه: قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا [ (9) التوبة: 81].
و أما النوع الثاني فله أمثلة.
أحدها و لم يذكر البلقيني غيره: الآيات العشر في براءة عائشة من سورة النور.
و أوّلها: إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ [ (24) النور: 11] ففي البخاري من حديثها فو اللّه ما رام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و لا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق و هو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. الحديث.
ثانيها: وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ [ (24) النور: 22] فإنها نزلت لما حلف أبو بكر رضي اللّه عنه لا ينفق على مسطح شيئا لما تكلّم في الإفك فهي قريبة مما قبلها.
ثالثها: قال الواحديّ: أنزل اللّه في الكلالة آيتين إحداهما في الشّتاء، و هي التي في أوّل النّساء، و الأخرى في الصيف و هي التي في آخرها، و عجبت للبلقيني كيف غفل عن هذه.
ص: 47
رابعها: ما في سورة الأحزاب من آيات غزوة الخندق، فقد كانت في البرد ففي حديث حذيفة: تفرّق النّاس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ليلة الأحزاب إلّا اثني عشر رجلا فأتاني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: «يا بن اليماني، قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر إلى حالهم» قلت: يا رسول اللّه، و الّذي بعثك بالحق ما قمت لك إلّا حياء من البرد. الحديث، و في بعض طرقه قال في آخره: فأنزل اللّه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ إلى آخرها. [ (33) الأحزاب: 9].
ذكر له البلقيني مثالا واحدا و هو آية الثّلاثة الذين خلفوا كما تقدّم أنّها نزلت و قد بقي من اللّيل الثّلث و هو صلّى اللّه عليه و سلّم عند أمّ سلمة، و ظفرت بمثال آخر، و هو: وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [ (5) النساء: 67] كما تقدم، و استشكل الجمع بين ما تقدّم من نزول الآية في بيت أم سلمة و قول النبي صلّى اللّه عليه و سلّم في حقّ عائشة: «ما نزل عليّ الوحي في فراش امرأة غيرها»، قال البلقيني: و لعل هذا كان قبل القصة التي نزل فيها الوحي في فراش أمّ سلمة.
قلت: ظفرت بما يحصل به الجواب و هو أحسن من هذا، فروى أبو يعلى في مسنده عن عائشة قالت: أعطيت تسعا- الحديث، و فيه: «و إن كان الوحي لينزل عليه و هو في أهله فينصرفون عنه، و إن كان لينزل عليه و أنا معه في لحافة». و على هذا لا معارضة بين الحديثين كما لا يخفى.
ذكره البلقيني و جعله ملحقا بما قبله و رأينا إفراده بنوع أليق، و مثّل بما في صحيح مسلم عن أنس قال: بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذا غفي إغفاءة ثم رفع رأسه متبسّما فقلنا: ما أضحكك يا رسول اللّه؟ فقال: أنزل علىّ آنفا سورة فقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ. إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
و قال الإمام الرّافعي في أماليه: فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة و قالوا: من الوحي ما كان يأتيه في النوم لأن رؤيا الأنبياء وحي قال: و هذا صحيح، لكن الأشبه أن يقال: إن القرآن كلّه نزل في اليقظة، و كأنه خطر له في النّوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة أو عرض عليه الكوثر التي وردت فيه السورة فقرأها عليهم و فسّرها لهم، قال: و ورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه و قد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي و يقال لها: برحاء الوحي. انتهى.
ص: 48
قلت: الذي قاله الرّافعيّ في غاية الاتجاه، و هو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه و التأويل الأخير أصحّ من الأول، لأن قوله: أنزل عليّ آنفا يدفع كونها نزلت قبل ذلك، بل نقول: نزلت في تلك الحالة و ليست الإغفاءة إغفاءة نوم، بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي، فقد ذكر العلماء أنّه كان يؤخذ عن الدّنيا.
و هو نوع مهم محتاج إليه و صنّف النّاس فيه مصنّفات، و من أحسنها كتاب الواحدي، ثم شيخ الإسلام حافظ العصر أبي الفضل بن حجر، و ما كان منه عن صحابي فهو مسند مرفوع، إذ قول الصحابي فيما لا دخل فيه للاجتهاد مرفوع، أو تابعيّ فمرسل، و شرط قبولهما صحّة السند، و يزيد الثاني أن يكون راويه معروفا بأن لا يروي إلّا عن الصحابة، أو ورد له شاهد مرسل أو متّصل و لو ضعيفا، و إذا تعارض فيه حديثان فإن أمكن الجمع بينهما فذاك كآية اللّعان، ففي الصّحيح عن سهل بن سعد السّاعديّ أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني و فيه أيضا أنها نزلت في قصة هلال بن أميّة، فيمكن أنها نزلت في حقهما أي بعد سؤال كل منهما فيجمع بهذا، و إن لم يمكن قدّم ما كان سنده صحيحا أو له مرجّح ككون راويه صاحب الواقعة التي نزلت فيها الآية و نحو ذلك، فإن استويا فهل يحمل على النّزول مرّتين أو يكون مضطربا يقتضي طرح كل منهما؟ عندي فيه احتمالان و في الحديث ما يشبهه، و ربما كان في إحدى القصتين فتلا فوهم الرّاوي فقال: فنزل كما تقدّم في آية الزّمر، و البارع النّاقد يفحص عن ذلك، و أمثلة هذا النّوع تستقرأ من الكتب المصنّفة فيه و ذكر منها كثير في هذا الكتاب في الأنواع السابقة و التي ستأتي.
ثم منها المشهور و هو قسمان: صحيح كقصة الإفك و آية السّعي و التّيمم و العزنيين و موافقات عمر، و ضعيف كآية: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها [ (4) النساء:
58]، و قد اشتهر أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة، و أسانيد ذلك بعضها ضعيف، و بعضها منقطع، و منها الغريب و هو أيضا قسمان: صحيح و ضعيف، و اللّه أعلم، و هذا الفصل مما حررته و استخرجته من قواعد الحديث و لم أسبق إليه و باللّه التوفيق.
اختلف في الأول، فالأصحّ أنه: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ و قيل: الْمُدَّثِّرُ، و قيل:
الفاتحة. حجّة الأوّل: حديث ابن عباس السابق في المكّيّ و المدنيّ، و حديث عائشة أنها قالت: أوّل ما نزل من القرآن اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ رواه في المستدرك.
ص: 49
و روى أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد:
أن أول ما نزل بمكة من القرآن: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، و ن، و القلم.
و حجّة الثّاني ما في الصّحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد اللّه: أيّ القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قلت: أو اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ؟ قال:
أحدّثكم بما حدثنا به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «إنّي جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي و خلفي و عن يميني و عن شمالي، ثم نظرت إلى السّماء فإذا هو- يعني جبريل- فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثّروني» فأنزل اللّه: يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ.
و أجاب الأول بما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و هو يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه «فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السّماء فرفعت رأسي فإذا الملك الّذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السّماء و الأرض فرجعت فقلت: زمّلوني زمّلوني فدثّروني فأنزل اللّه: يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. فقوله: الملك الّذي جاءني بحراء دالّ على أن هذه القصّة متأخّرة عن قصة حراء التي نزل فيها: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.
قال البلقيني: و يجمع بين الحديثين بأن السؤال كان عن نزول بقيّة: اقْرَأْ و المدّثّر، فأجابه بما تقدم.
و حجّة الثّالث: و لم يذكره البلقيني ما رواه البيهقي في الدلائل عن أبي ميسرة عمرو ابن شرحبيل أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قال لخديجة: «إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء» فذكر الحديث و فيه: فأتى ورقة بن نوفل فقصّ عليه فقال له: إذا أتاك فاثبت له حتّى تسمع ما يقول ثم ائتني فاخبرني فلما خلا ناداه: يا محمّد قل: بسم اللّه الرّحمن الرحيم. الحمد للّه ربّ العالمين.
حتى بلغ: و لا الضّالين، فأتى ورقة بن نوفل فذكر ذلك له فقال له: أبشر الحديث.
قال البيهقي: هذا منقطع و إن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه اقْرَأْ و المدّثّر.
قلت: و إن صح أخذ منه أنها من أوائل ما نزل كما لا يخفى.
قال البلقيني: و أول سورة نزلت بالمدينة: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ في قول عليّ بن الحسين، و قال عكرمة: بل البقرة، و كلاهما مرسل بلا إسناد.
قلت: أما مرسل فصحيح، و أما بلا إسناد فقد تقدم مسندا عن عكرمة و الحسن أن أوّل ما نزل بها: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ثم البقرة، بل و عن ابن عباس فانتفى الإرسال أيضا.
ص: 50
و أسند أبو داود في الناسخ و المنسوخ من طريق حسّان بن إبراهيم الكرماني عن أميّة الأزدي عن جابر بن زيد و هو من علماء التابعين بالقرآن قال: أوّل ما أنزل اللّه على محمد صلّى اللّه عليه و سلّم من القرآن بمكة: (اقرأ) ثم: (ن) و سرد سائر السور المتقدمة في النوع الأول عن عكرمة على الترتيب عاطفا كل سورة بثم، و ذكر بين: ص و الجن: الأعراف، و بين الملائكة و طه: كهيعص، و سمّى يونس السّابعة، و قال حم المؤمن ثم حم السّجدة ثم الأنبياء، ثم النّحل أربعين منها، و بقيتها بالمدينة ثم نوح، ثم الطّور، ثم المؤمنون، ثم الملك، و قدّم: إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ على: إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ و قال بعد العنكبوت ثم وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ فذاك ما نزل بمكة، ثم قال: و أنزل بالمدينة سورة البقرة فذكر سائر السّور كما تقدم، و جعل الصّفّ بعد التغابن. و من أوائل ما أنزل بمكّة: الإسراء و الكهف و طه و مريم (1).
ففي البخاري عن عبد اللّه بن مسعود أنه قال: إنّهنّ من العتاق الأول، قال أبو عبيد:
يقول إنه من أوّل ما أخذت من القرآن فشبّهه بتلاد المال القديم.
و في البخاري عن عائشة: أوّل ما نزل سورة من المفصّل فيها ذكر الجنّة و النّار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال و الحرام لقد نزلت بمكة و إنّي جارية ألعب وَ السَّاعَةُ أَدْهى وَ أَمَرُّ [ (54) القمر: 46] و من أوائل ما نزل بالمدينة: الأنفال كما في الحديث المشهور عن عثمان أخرجه الحاكم و غيره.
فرع: من هذا النوع
أوّل آية نزلت في القتال مطلقا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا [ (22) الحج: 39].
رواه الحاكم و غيره عن ابن عباس.
و أول آية نزلت فيه بالمدينة: وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ [ (2) البقرة:
190] حكاه ابن جرير.
و أول آية نزلت في الأطعمة بمكة آية الأنعام: إلى آخرها قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً [ (6) الأنعام: 145] ثم آية النّحل: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ [ (16) النحل: 114]
ص: 51
و بالمدينة: آية البقرة: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ [ (2) البقرة: 219] الآية. ثم آية المائدة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [ (5) المائدة: 3] الآية قاله ابن الحصّار.
و أوّل آية نزلت في الخمر يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ [ (2) البقرة: (219] ثم آية النّساء، ثم آية المائدة، رواه الترمذي و غيره من حديث عمر و صححه، و قاله جماعة منهم:
ابن عمر و الشعبي و مجاهد و قتادة و الربيع بن أنس.
و أما آخر ما نزل: فروى الشيخان عن البراء بن عازب أنّه قال آخر آية نزلت:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [ (4) النساء: 176] و آخر سورة نزلت: براءة.
و أخرج البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت: آية الرّبا. و روى البيهقي عن عمر مثله، و أخرج أبو عبيد عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا و آية الدّين.
و أخرج النسائي عن ابن عباس: آخر آية نزلت: وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ [ (2) البقرة: 281] و رواه البيهقي في الدلائل و زاد: و بينها و بين موت النبي صلّى اللّه عليه و سلّم أحد و ثمانون يوما، و روي أيضا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أحد و ثلاثون يوما. و روى أبو عبيد عن ابن جريج قال: زعموا أنه صلّى اللّه عليه و سلّم مكث بعدها سبع ليال و بدئ يوم السّبت و مات يوم الاثنين و روى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ [ (9) التوبة: 128، 129] إلى آخر السورة.
و روى مسلم عن ابن عباس آخر سورة نزلت: إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ.
و روى الترمذي و الحاكم عن عائشة: آخر سورة نزلت المائدة فما وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه، و ما وجدتم فيها من حرام فحرّموه، و روى الحاكم مثله أيضا عن عبد اللّه ابن عمرو و عثمان في حديثه المشهور: براءة من آخر القرآن نزولا.
قال البيهقي: و يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد جاء بما عنده و لم يذكر البلقيني من هذه الأقوال إلّا القليل. و من أغرب ما روي في هذا النوع ما رواه ابن جرير قال: حدّثنا أبو عامر السكوني حدّثنا هشام بن عمار حدّثنا ابن عباس حدّثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ [ (18) الكهف: 110] و قال: إنّها آخر آية نزلت من القرآن، قال ابن كثير: و هو أثر مشكل و لعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها و لا تغيّر حكمها بل هي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك على بعض الرواة فرواه بالمعنى على ما فهمه.
ص: 52
و هذا النوع من زيادتي و هو مهم و له أمثله، أوّلها و ثانيها: اقرأ و الفاتحة نزلتا عام المبعث لأنه مقارب لهما، و عام المبعث سنة أربعين من مولده صلّى اللّه عليه و سلّم، و مولده: عام الفيل هذا هو الصحيح في الأمرين الثابت في البخاري. و قيل: عام ثلاث و أربعين من مولده، و قيل: بعث عام أربعين و لم ينزل عليه القرآن إلّا بعد ثلاث سنين، و ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن اليوم الذي أنزل فيه يوم الاثنين، قال ابن إسحاق: و كان في شهر رمضان.
ثالثها: المدّثّر نزلت بعد اقرأ بسنتين أو أكثر كما في الصّحيح.
الرابع: آية القبلة في السنة الثانية من الهجرة في رجب ففي الصحيح عن البراء أنه صلّى اللّه عليه و سلّم صلّى إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا و كان يجبّ أن يتوجّه إلى الكعبة فأنزل اللّه: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [ (2) البقرة: 144] فتوجّه نحو الكعبة فقال السّفهاء من النّاس: ما ولّاهم عن قبلتهم الّتي كانوا عليها فأنزل اللّه: قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ [ (2) البقرة: 142] الحديث، و فيه أن أول صلاة صلاها العصر، فيكون نزولها بين الظهر و العصر، و في رواية في الصحيحين أنها نزلت ليلا و سبق بيانها.
و قال ابن حبيب: نزلت في صلاة الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان.
الخامس: وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [ (2) البقرة: 115] اختلف فيها فروى مسلم عن ابن عمر: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يصلي و هو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، و فيه نزلت.
قال ابن الحصّار: و هو صلّى اللّه عليه و سلّم لم يدخل مكة بعد الهجرة إلّا عام القضية سنة سبع و عام الفتح سنة ثمان و عام حجة الوداع سنة عشر، و هذا أصح ما يعتمد عليه في نزولها.
السادس: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى [ (2) البقرة: 125].
قال ابن الحصار: نزلت إما عام القضية أو الفتح أو الوداع.
السابع: آية الصّيام في السنة الثانية في شعبان.
الثامن: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ [ (2) البقرة: 196]. سنة ستّ في ذي القعدة.
ص: 53
التاسع: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ [ (2) البقرة: 217] نزلت في سرية عبد اللّه بن جحش سنة اثنتين في رجب.
العاشر: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ [ (2) البقرة: 256]، روى ابن حبان و غيره عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل اللّه هذه الآية و أجلي بنو النضير في ربيع الأول سنة أربع.
الحادي عشر: من أول آل عمران إلى ثلاث و ثمانين آية نزل في وفد نجران سنة تسع رواه ابن إسحاق في السيرة.
الثاني عشر: ما فيها من قصة أحد و أوّله: وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ [ (3) آل عمران:
121]، سنة ثلاث في أواخرها، و كان يوم الوقعة يوم السبت لإحدى عشرة خلت من شوّال، و قيل: يوم النصف منه.
الثالث عشر: وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ [ (3) آل عمران: 199]، الآية نزلت كما روى ابن جرير و ابن مردويه من حديث جابر أنه صلّى اللّه عليه و سلّم صلّى على النجاشي حين مات فقال المنافقون: يصلّي على علج مات بأرض الحبشة فنزلت هذه الآية.
و روى ابن مردوية نحوه من حديث أنس، و مات النجاشي سنة تسع.
الرابع عشر: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [ (4) النساء: 11]: نزلت بأثر أحد كما روى أبو داود و الترمذي و غيرهما عن جابر: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول اللّه:
هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك في أحد و إن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا فنزلت آية الميراث.
الخامس عشر: وَ الْمُحْصَناتُ (مِنَ النِّساءِ) [ (4) النساء: 24] روى مسلم عن أبي سعيد أن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهنّ أزواج فكرهوا غشيانهنّ فنزلت هذه الآية، و أوطاس: هي غزوة حنين مكة سنة ثمان بعد الفتح بقليل.
السادس عشر: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ [ (4) النساء: 58]، يوم فتح مكة سنة ثمان في رمضان.
السّابع عشر: فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ [ (4) النساء: 88] بأثر أحد كما في
ص: 54
الصحيحين عن زيد بن ثابت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم خرج إلى أحد فرجع ناس فكان الصحابة فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم، و فرقة تقول: لا فنزلت.
الثامن عشر: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً [ (4) النساء: 92]، و قال مجاهد، و غيره: نزلت يوم الفتح.
التاسع عشر: آية القصر [في النساء: 101] سنة أربع.
العشرون: آية صلاة الخوف [في النساء: 102]، في غزوة ذات الرّقاع في المحرّم سنة خمس.
الحادي و العشرون: آية الكلالة [في النساء: 176]، في حجة الوداع.
الثّاني و العشرون: أول المائدة بها أيضا.
الثالث و العشرون: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [ (5) المائدة: 3]، فيها أيضا يوم عرفة يوم الجمعة و النبي صلّى اللّه عليه و سلّم واقف بها، و في رواية عن ابن عباس عند البيهقي في الدلائل يوم الاثنين و هو مخالف لما في الصحيح.
الرابع و العشرون: آية التّيمّم [في المائدة: 6]، بها في القفول من غزوة المريسيع و كانت في شعبان سنة ست و قيل سنة خمس و قيل سنة أربع.
الخامس و العشرون: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الآية [ (5) المائدة: 33]، في قصة العرنيّين في سنة ست، و آية تحريم الخمر [المائدة: 90] في محاصرة بني النضر في ربيع الأول سنة أربع.
السادس و العشرون: سورة الأنفال. بعضها يوم بدر، و بعضها بأثرها، و كانت في رمضان سنة اثنتين.
السابع و العشرون: براءة سنة تسع، بعضها في غزوة تبوك، و كان مقدمه منها في رمضان.
و منها آية الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا [ (9) التوبة: 118]، بعد مقدمه بخمسين ليلة.
الثامن و العشرون: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ إلى شَدِيدُ الْمِحالِ [ (13) الرعد:
11، 12]، نزلت لما قدم وفد بني عامر و قدومهم سنة تسع.
التّاسع و العشرون: خواتيم سورة النّحل إما يوم أحد أو يوم الفتح كما تقدم.
ص: 55
الثلاثون: أول الإسراء عام الإسراء و اختلف فيه، فقيل: قبل الهجرة بسنة، و قيل:
بأحد عشر شهرا، و قيل: بثمانية أشهر، و قيل: بستة أشهر، و قيل: بخمسة عشر شهرا، و قيل: بسبعة عشر، و قيل: بثمانية عشر، و قيل: بعشرين، و قيل: بثلاث سنين، و قيل:
بخمس، و قيل: كان بعد البعثة بخمس سنين، و قيل: بخمسة عشر شهرا، و قيل: بعام و نصف، و اختلف في الشهر فقيل: ربيع الأول، و قيل: الآخر، و قيل: رجب، و قيل:
رمضان، و قيل: شوال. و قد بسطت الكلام على هذه الأقوال في شرح الأسماء النّبويّة.
الحادي و الثلاثون: هذانِ خَصْمانِ [ (22) الحج: 19]، يوم بدر أو بإثره.
الثّاني و الثلاثون: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ [ (22) الحج: 29]، في سفر الهجرة و كان في ربيع الأول بعد النبوة بثلاث عشرة سنة، و قيل: عشر سنين.
الثالث و الثلاثون: قصة الإفك سنة غزوة بني المصطلق و هي غزوة المريسيع و تقدم تاريخها.
الرابع و الثلاثون: آية الاستئذان [في النور: 58]، في النور سنة عشر.
الخامس و الثلاثون: آية الحجاب [في الأحزاب: 59]، و الآية في تزويج زينب بنت جحش سنة أربع [في الأحزاب: 37].
السّادس و الثلاثون: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ [ (28) القصص: 56]، في وفاة أبي طالب، و كذا أول: ص، و كانت وفاته سنة عشر من المبعث قبل الهجرة بثلاث سنين.
السابع و الثلاثون: ما في الأحزاب من آيات الخندق و كانت في شوال سنة خمس، و قيل: أربع.
الثامن و الثلاثون: آخر الأحقاف في قصة الجن سنة عشر من النبوة.
التّاسع و الثلاثون: سورة القتال سنة ست.
الأربعون: سورة الفتح سنة ست في ذي القعدة.
الحادي و الأربعون: أول المجادلة سنة ست.
الثاني و الأربعون: الحشر في بني النضير سنة خمس في ربيع الأول بعد خمسة أشهر من أحد، و قيل: بعد ستة و ثلاثين شهرا منها.
الثالث و الأربعون: سورة المنافقين، في غزوة بني المصطلق أو تبوك كما تقدم.
ص: 56
الرّابع و الأربعون: سورة النّصر نزلت في أوسط أيّام التشريق عام حجة الوداع، رواه البزّار و البيهقي.
فهذه عيون أمثلتها و لم نستوعبها حذرا من التصويل، و فيما تقدم من الأنواع أمثله تدخل في هذا النوع، و في هذا النوع أمثلة للسفري غير ما تقدم.
هذان النوعان من زيادتي.
و من أمثلة الأول: الفاتحة و خواتيم سورة البقرة، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس:
أتى النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم ملك و قال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبيّ قبلك: فاتحة الكتاب، و خواتيم سورة البقرة.
و أما الثاني: فأمثلته كثيرة، فروى الحاكم و صححه من طريق عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قال صلّى اللّه عليه و سلّم: «كلّها في صحف إبراهيم و موسى»، فلما نزلت وَ النَّجْمِ إِذا هَوى فبلغ: وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى قال: وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى إلى قوله: هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى، و روي أيضا من طريق القاسم عن أبي أمامة قال: أنزل اللّه على إبراهيم مما أنزل على محمد التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ إلى قوله: وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [ (9) التوبة: 112] قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ إلى قوله: فِيها خالِدُونَ [ (23) المؤمنون: 1، 11]، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ [ (33) الأحزاب: 35]، و التي في سأل الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ إلى قوله: قائِمُونَ [ (70) المعارج: 23، 33]، فلم يف بهذه السّهام إلّا إبراهيم و محمد صلّى اللّه عليه و سلّم.
و روى أيضا من طريق عطاء عن ميسرة أن هذه الآية مكتوبة في التوراة بسبعمائة آية يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ أول سورة الجمعة.
و روى البخاريّ من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه يعني النبي صلّى اللّه عليه و سلّم الموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً و حرزا للأميين الحديث.
و روى البيهقي في الشعب من طريق الوليد بن العيزار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: السّبع الطوال لم يعطهنّ أحد إلّا النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، و أعطي موسى منها اثنتين. و روى
ص: 57
أيضا من طريق أبي المليح عن معقل بن يسار قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول و أعطيت طه و الطواسين و الحواميم من ألواح موسى، و أعطيت فاتحة الكتاب و خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، و المفصّل نافلة»، فالظاهر أن (من) في قوله: «من ألواح موسى» للتبعيض كهي فيما بعده، و يحتمل أن تكون للبدل فلا يكون مما أعطي موسى.
و روى أبو عبيد بن كعب قال: أول ما أنزل اللّه في التوراة: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم: قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ الآيات و بقي أمثلة أخرى.
و قد يدخل في هذا النوع البسملة لأنها نزلت على سليمان. و قد روى الدار قطني و غيره من حديث بريدة أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «لأعلّمنك آية لم تنزل على نبيّ بعد سليمان غيري فذكرها».
و روى البيهقي عن ابن عباس: أغفل النّاس آية من كتاب اللّه لم تنزل على أحد سوى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم إلّا أن يكون سليمان بن داود فذكرها.
هذا النوع من زيادتي، و قد صرح جماعة من المتقدمين و المتأخرين بأن من القرآن ما تكرّر نزوله، و ذكر منه ابن الحصار: خواتيم سورة النّحل و أول سورة الروم كما سبق.
و قال: قد يتكرر نزول الآية تذكيرا و موعظة، و ذكر منه ابن كثير: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ [ (17) الإسراء: 85]، و ذكر منه جماعة الفاتحة، و منه كل ما اختلف في سبب نزوله أو تأخر وقته و سند كل من الروايتين صحيح و لم يمكن الجمع و هو أشياء كثيرة، و من راجع أسباب النزول وجد من ذلك كثيرا، و منه البسملة فقد نزلت في أول كل سورة، و في النّمل، و روى أبو داود من حديث ابن عباس كان النبي صلّى اللّه عليه و سلّم لا يعرف فصل السّورة حتى ينزل عليه: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم [زاد البزار (1)] فإذا نزلت عرف أن السّورة قد ختمت و استقبلت أو ابتدئت سورة أخرى، و الأحاديث الدالة على نزول البسملة أول كل سورة إلّا «براءة» لا تحصى كثرة، و عندي أنها بلغت مبلغ القطع و التواتر، و إنما لم يكفر نافيها لشبهة الخلاف و كما لا يكفر منكر المتواتر من الحديث، و يلحق بهذا النوع الآيات التي كرّرت في معنى واحد كالقصص و الأوامر و النواهي، و فائدتها: التأكيد، و لتجديد الأمر في القلوب وقع.
ص: 58
هذان النوعان من زيادتي، و الأول كثير لأنه غالب القرآن و من أمثلته في السور القصار: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أول ما نزل منها إلى قوله: ما لَمْ يَعْلَمْ، و الضّحى، ففي الصحيحين أول ما نزل منها إلى قوله وَ ما قَلى و في الحديث أن:
وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى نزلت وحدها و روى ابن جرير أنّ: وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى نزلت وحدها، و كذلك سورة الليل غالب آياتها نزلت مفرقة.
و أما النوع الثاني فمنه الأنعام إن صح الحديث السابق فيها و منه سورة الصّفّ؛ ففي المستدرك و غيره من حديث عبد اللّه بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فقلنا:
لو نعلم أيّ الأعمال أحبّ إلى اللّه عملناه فأنزل اللّه سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إلى آخر السورة، فقرأها علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم.
و منه «المرسلات» ففي المستدرك عن ابن مسعود قال: كنّا مع النبي صلّى اللّه عليه و سلّم في غار فنزلت عليه: وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً فأخذتها من فيه، و إن فاه رطب بها فلا أدري بأيها ختم: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ [ (77) المرسلات: 50] أو وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ [ (77) المرسلات: 48].
و منه: سورة العصر و الكوثر و النّصر و تبّت و الإخلاص، و منه: الفاتحة خلافا لما حكي عن أبي الليث أنها نزلت نصفين، و من هذا النوع سورتان نزلتا معا و هما:
المعوّذتان.
هذا النوع من زيادتي و فيه مسائل: الأولى في نزوله من اللّوح المحفوظ. و روى الحاكم في المستدرك و البيهقي من طريق منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا و كان بمواقع النّجوم، و كان اللّه ينزله على رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم بعضه في إثر بعض.
و روى الحاكم أيضا من طريق يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عكرمة من ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السّماء الدّنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة. و روى أيضا من طريق سفيان عن الأعمش عن حسان بن حريث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذّكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا.
ص: 59
و روى ابن مردويه من طريق السّدي عن محمد بن أبي المجالد عن معمر عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال: أوقع في قلبي الشّكّ قوله تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ [ (2) البقرة: 185].
و قوله: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ و هذا نزل من شوال و ذا في ذي القعدة إلى آخره (1)، فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور و الأيام.
و روى أحمد في مسنده عن واثلة بن الأسقع أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، و أنزلت التّوراة لستّ مضين من رمضان، و الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، و أنزل اللّه القرآن لأربع و عشرين خلت من رمضان».
قال الفخر الرّازي: و يحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج النّاس إلى إنزاله إلى مثلها من اللوح إلى سماء الدنيا و توقف، و هل هذا أولى أو الأول؟ قال ابن كثير:
و هذا الذي جعله احتمالا نقله القرطبي عن مقاتل و ابن حيّان، و حكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللّوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.
قلت: و يوافق قول الرازي و مقاتل: و ما تقدم عن ابن شهاب أنه قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الرّبا و آية الدين.
الثانية: في قدر ما كان ينزل منه. روى البيهقي في شعب الإيمان من طريق وكيع عن خالد بن دينار قال: قال لنا أبو العالية: تعلّموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم كان يأخذه من جبريل خمسا خمسا، ثم روى مثله من طريق أبي جلدة عن أبي العالية، عن عمر و لفظه: فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلّى اللّه عليه و سلّم خمسا خمسا، قال:
و رواية وكيع أصح.
قلت: و له شاهد عن علي سيأتي في المسلسل، و في النفس من هذا كلّه شي ء، و الذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة و غيرها أن القرآن كان ينزل على حسب الحاجة خمسا و عشرا و أكثر و أقلّ و آية و آيتين، و قد صح نزول قصة الإفك جملة و هي عشر آيات و نزول بعض آية و هي قوله تعالى: غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ [ (4) النساء: 95].
الثالثة: كيفية الإنزال و الوحي: قال شيخنا العلّامة الكافيجي و قبله الطيبي: لعلّ نزول القرآن على الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم أن يتلقّفه الملك من اللّه تلقّفا روحانيا أو يحفظه من اللّوحع.
ص: 60
المحفوظ فينزل به إلى الرسول و يلقيه عليه، و قد ذكر العلماء للوحي كيفيات: إحداها: أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس و هو أشدّه عليه كما في الصحيح، الثانية: أن ينفث في روعه الكلام نفثا كما قال صلّى اللّه عليه و سلّم: «إنّ روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتّى تستكمل رزقها».
الرابعة: أن يأتيه فيكلّمه كما في حديث ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «كان من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا و إن جبريل يأتيني فيكلّمني كما يأتي أحدكم صاحبه فيكلّمه».
الخامسة: أن يكلّمه اللّه إما في اليقظة كما في ليلة الإسراء أو في النوم كما في حديث معاذ: «أتاني ربّي في أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى». الحديث.
السادسة: أن يأتيه الملك في النّوم، و في الصّحيح: أوّل ما بدئ به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم من الوحي الرّؤيا الصادقة، قال ابن سيّد النّاس: و عن الشّعبي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم وكّل به إسرافيل فكان يتراءى له ثلاث سنين و يأتيه بالكلمة من الوحي ثم وكّل به جبريل فجاءه بالقرآن و الوحي، قال: فهذه حالة سادسة. و أما إتيان الملك فتارة كان يأتيه في صورته له ستمائة جناح و تارة في صورة دحية الكلبي.
السابعة: في الأحرف التي ورد الحديث بنزول القرآن بها، و الكلام في ذلك في مسائل: الأولى: في بيان الحديث فروى الشّيخان من حديث عمر قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ الفرقان في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فكدت أساوره في الصّلاة فصبرت حتى سلّم فلبّبته بردائه فقلت:
من أقرأك هذه السورة؟ فقال: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، فقلت: كذبت! فانطلقت به أقوده إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال: «أرسله اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها فقال: «كذلك أنزلت» ثم قال: «اقرأ يا عمر» فقرأت القراءة التي أقرأني فقال: «كذلك أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسّر منه».
و روينا عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده و يزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف».
و عند مسلم من حديث أبيّ: «إنّ ربي أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هوّن على أمّتي، فأرسل إليّ أن اقرأ على حرفين فرددت إليه أن هوّن على أمّتي فأرسل إليّ أن اقرأه على سبعة أحرف»، و في لفظ عنه عند النّسائي: «إن جبريل و ميكائيل
ص: 61
أتياني فقعد جبريل عن يميني و ميكائيل عن يساري فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل: استزده حتّى بلغ سبعة أحرف، و كلّ حرف كاف شاف» و في لفظ عنه عن ابن جرير: «إن اللّه أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحد فقلت: خفّف عن أمّتي، فقال:
اقرأه على حرفين فقلت: خفّف عن أمتي، فأمرني أن أقرأ على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة كلّها شاف كاف»، و في لفظ عند مسلم: «فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا». و في لفظ لأبي داود عنه: «ليس منها إلّا شاف كاف».
قلت: سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، و في لفظ للترمذي عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم لجبريل: «إني بعثت إلى أمّة أميين فيهم الشيخ الفاني و العجوز الكبيرة و الغلام» فقال: مرهم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف.
و رواه أحمد بهذا اللفظ من حديث حذيفة و زاد: «فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم و لا يرجع عنه»، و في لفظ له. «فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه» و في لفظ له عن أبي بكرة: «كلّها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة»، و زاد ابن جرير عنه كقولك: هلمّ، و تعال و في لفظ لأحمد عن أم أيوب أنها قرأت أجزأك.
و روى ابن جرير عن ابن مسعود عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، و نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر، و آمر، و حلال، و حرام، و محكم، و متشابه، و أمثال، فأحلّوا حلاله، و حرّموا حرامه، و افعلوا ما أمرتم به، و انتهوا عمّا نهيتم عنه، و اعتبروا بأمثاله، و اعملوا بمحكمه، و آمنوا بمتشابهه و قولوا: آمنّا به كلّ من عند ربّنا». ثم رواه عنه موقوفا. قال ابن كثير: و هو أشبه.
و روينا حديث السبعة الأحرف عن جماعة من الصحابة غير من تقدم و هم: عبد الرحمن بن عوف: و معاذ، و أبو هريرة، و أبو سعيد الخدري و عمرو بن العاص، و زيد بن أرقم، و سمرة، و أنس، و عمر بن أبي سلمة و أبو جهيم، و أبو طلحة الأنصاري، و سليمان ابن صرد، و الخزاعي.
و في مسند أبي يعلى أن عثمان قال على المنبر: اذكر اللّه رجلا سمع النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قال:
«إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلّها شاف كاف» لمّا قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك فقال: و أنا أشهد معهم.
و قد نص أبو عبيد على أن هذا الحديث تواتر عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم.
الثانية: اختلف في المقصود بهذه السّبعة على نحو أربعين قولا، و أنا أذكر منها ما هو أوجه و أشبه فقال خلق منهم: سفيان بن عيينة و ابن جرير و نسبه بعضهم لأكثر العلماء:
ص: 62
إن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل، و تعال، و هلمّ، كما تقدم لي بعض ألفاظ أبي بكرة و روي عن أبيّ أنّه كان يقرأ: يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا [ (57) الحديد: 13] للّذين آمنوا أمهلونا- للّذين آمنوا أخّرونا- للّذين آمنوا ارقبونا- و كان يقرأ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ [ (2) البقرة: 20] مرّوا فيه- سعوا فيه.
قال الطّحاوي: و إنما كان ذلك رخصة أن يقرأ النّاس القرآن على سبع لغات لما كان يتعسّر على كثير منهم التلاوة على لغة قريش و قراءة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم لعدم علمهم بالكتابة و الضبط و إتقان الحفظ ثم نسخ بزوال العذر و تيسّر الكتابة و الحفظ، و كذا قال ابن عبد البر، و القاضي الباقلاني.
و قال آخرون و روي عن ابن عباس: نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن، قال أبو عبيد و هم: بنو سعد بن بكر، و جشم، و نصر بن معاوية، و ثقيف، و هو أفصح العرب، و الأخريان: قريش، و خزاعة. و قال الهروي: المراد على سبع لغات، أي أنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش، و بعضه بلغة هوازن، و بعضه بلغة هذيل.
و قال بعضهم: المراد بها: معاني الأحكام كالحلال و الحرام، و المحكم و المتشابه و الوعد و الوعيد و نحو ذلك، و كل ذلك ضعيف ما عدا الأول فإنه أقرب، و الصواب أن المراد بها اختلاف القراءات.
ثم قال أبو عبيد: ليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف و لكن بعضه على حرف و بعضه على آخر، و اختاره ابن عطيّة و كذا قال أبو عمرو الدّاني: المراد على سبعة أوجه و أنحاء من القراءات قال قوم: ليس المراد بالسّبعة الحصر فيها بحيث لا يزيد و لا ينقص بل السّعة و التيسير و أنه لا حرج عليهم في قراءته بما أذن لهم فيه و العرب يطلقون لفظ السّبعة و السّبعين و السّبعمائة و لا يريدون حقيقة العدد بل التكثير، و ردّه ابن الجزري بأن في بعض ألفاظه: «فنظرت إلى ميكائيل فسكت- فعلمت أنه قد انتهت العدة، فدل على أن حقيقة العدد و انحصاره مراد، قال: و قد تتبعت صحيح القراءات و شاذّها و ضعيفها و منكرها فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها و ذلك: إما في الحركات بلا تغيّر في المعنى و الصّورة نحو: بِالْبُخْلِ [ (4) النساء: 37]، بأربعة و يحسب بوجهين، أو بتغيّر في المعنى فقط نحو: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ [ (2) البقرة: 37]، و إما في الحروف بتغيّر المعنى لا الصورة نحو: (نبلو) (تتلو) أو عكس ذلك نحو: الصّراط- السّراط، أو بتغيّرهما نحو: و امضوا و اسعوا.
ص: 63
و إمّا في التّقديم و التأخير نحو فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ [ (9) التوبة: 111]، أو في الزيادة و النقصان نحو: (أوصى و وصّى) [ (2) البقرة: 132]، فهذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها.
و أما نحو اختلاف الإظهار و الإدغام و الرّوم و الإشمام و التحقيق و التسهيل و النّقل و الإبدال فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللّفظ و المعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا.
و قد ظن كثير من العوام و الجهلة أن السبعة الأحرف هي قراءات القراء السبعة و هو جهل قبيح.
الثالث: اختلف هل المصاحف العثمانيّة مشتملة على جميع الأحرف السبعة فذهب جماعات من الفقهاء و القرّاء و المتكلّمين إلى ذلك و بنوا عليه أنه لا يجوز على الأمّة أن تهمل نقل شي ء منها.
و قد أجمع الصّحابة على نقل المصاحف العثمانيّة من الصحف التي كتبها أبو بكر و عمر، و أجمعوا على ترك ما سوى ذلك.
قال ابن الجزري: و ذهب جماهير العلماء من السّلف و الخلف و أئمة المسلمين إلى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم على جبريل متضمّنة لها لم تترك حرفا منها، و هذا الذي يظهر صوابه، و يجاب عن الأوّل بما قال ابن جرير: إن القراءة على الأحرف السّبعة لم تكون واجبة على الأمة و إنما كان جائزا لهم و مرخّصا لهم فيها فلما رأى الصّحابة أن الأمة تفترق و تختلف إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا شائعا و هم معصومون من الضّلالة و لم يكن في ذلك ترك وجب و لا فعل حرام و لا شك أن القرآن نسخ منه في العرضة الأخيرة و غيّر فاتفق الصحابة على أن يكتبوا ما تحقق أنه قرآن مستقر في العرضة الأخيرة و تركوا ما سوى ذلك.
الرابعة: السّبب في نزول القرآن على هذه الأحرف التّيسير و التّسهيل على هذه الأمة، و النهاية في إعجاز القرآن و إيجازه و بلاغة اختصاره إذ تنوّع اللّفظ بمنزلة آيات و لو جعل دلالة على كل آية لم يخف ما فيه من التطويل، و إظهار شرف القرآن بعد تطرّق التّضادّ و التناقض إليه مع كثرة هذه الاختلافات و التنوّعات، و إعظام أجور الأمة في إفراغهم الجهد في تتبّع معاني ذلك و استنباط الحكم و الأحكام من كلّ لفظة، و إظهار فضلها إذ لم ينزل كتاب غيرهم إلّا على لفظ واحد تشريفا لنبيّنا عليه أفضل الصّلاة و السّلام.
ص: 64
قال البلقيني: اعلم أن القراءة تنقسم إلى متواتر و آحاد و شاذ، فالمتواتر: القراءات السّبع المشهورة، و المراد بذلك: ما قرءوه من الحركات و الحروف دون ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الإمالة، و المد، و التخفيف فليس بمتواتر. نعم أصل المدّ و الإمالة و التخفيف متواتر لاشتراك القرّاء فيه، و أما ما عدا السبعة من قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع و يعقوب و اختيارات خلف التي هي تمام العشر، فإنها ليست من المتواتر على الأرجح، و من جعلها منه من المتأخّرين ففي قوله نظر لأن المتواتر في السّبع إنما جاء من تلقّي أهل الأمصار لها من غير نكير، و قراءة المذكورين لم يتلقّها أهل الأمصار كتلقّي تلك القراءات و الّذي يظهر أنّ هذه القراءات يطلق عليها آحاد و تلحق بالآحاد: قراءات الصحابة، أما قراءات التابعين كابن جبير و يحيى بن وثّاب و الأعمش و نحوهم فمعدودة من الشّاذ إذ لم تشتهر كباقي العشرة و لو كان في الحديث لأطلق عليه مرسل.
و لا يقرأ في الصّلاة إلّا بالمتواتر دون الآحاد و الشّاذ، و مما يدلّ على هذا التقسيم أن الأصحاب تكلّموا على القراءة الشّاذّة فقالوا: إن جرت مجرى التّفسير و البيان عمل بها، و إن لم يكن كذلك فإن عارضها خبر مرفوع قدم عليها أو قياس ففي العمل لها قولان فأنزلوا قراءة الصّحابة منزلة خبر الواحد، و القراءات الثّلاث متصلة بالصّحابة. انتهى كلامه.
و فيه أنظار في مواضع منه تعرف مما سنذكره، فقال السّبكيّ في شرح المنهاج: قالوا تجوز القراءة في الصّلاة و غيرها بالسّبع و لا تجوز بالشّاذّ و ظاهر هذا يوهم أن غير السّبع شاذّ، و قد نقل البغويّ في تفسير الاتّفاق على القراءة بالثّلاث أيضا. قال: و هذا هو الصّواب، قال: الخارج عن السّبع منه ما يخالف رسم المصحف فلا شكّ في تحريم القراءة به، و منه ما لا يخالفه و لم تشتهر القراءة به بل ورد من طريق غريبة لا يعوّل عليها، و هذا يظهر المنع من القراءة به أيضا.
و منه ما اشتهر عند أئمّة هذا الشأن القراءة به قديما و حديثا، فهذا لا وجه للمنع منه، و من ذلك قراءة يعقوب و غيره، قال: و البغويّ أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم. قال: و هكذا التّفصيل في شواذّ السّبعة فإن عنهم شيئا كثيرا شاذّا، انتهى.
و قال ولده في منع الموانع: القول بأنّ الثّلاث غير متواترة في غاية السّقوط و لا يصحّ القول به عمّن يعتبر قوله في الدّين و هي لا تخالف رسم المصحف. قال: و قد سمعت
ص: 65
الشّيخ الإمام يعني والده يشدّد النكير على بعض القضاة و قد بلغه أنّه منع القراءة بها؛ و كذا قال ابن الصّلاح في فتاويه: يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قرآنا و استفاض و تلقّته الأمّة بالقبول: فما لم يوجد فيه ذلك ممّا عدا السّبع أو العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة، لأن المعتبر في ذلك اليقين و القطع على ما تقرّر في الأصول.
و قال ابن الجزريّ في النّشر: كلّ قراءة وافقت العربية و لو بوجه و وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا و صحّ سندها فهي القراءة الصّحيحة التي لا يجوز ردّها و لا يحلّ إنكارها سواء كانت عن السّبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمّة المقبولين، و متى اختلّ ركن من الثّلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذّة باطلة سواء كانت عن السّبعة أو عمّن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السّلف و الخلف صرّح بذلك أبو عمرو الدّاني و مكّي و أبو العبّاس و المهدوي و أبو شامة و نقل مثله عن الكواشي و أبي حيان، قال:
و هو مذهب السّلف الّذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.
قال أبو شامة: فلا ينبغي أن نغترّ بكلّ قراءة تعزى إلى واحد من الأئمة السّبعة و يطلق عليها لفظ الصّحّة و أنّها هكذا أنزلت إلّا إذا دخلت في هذا الضّابط و حينئذ لا ينفرد بنقلها مصنّف عن غيره، و لا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القرّاء لم تخرج عن الصّحّة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه فإن القراءة المنسوبة إلى كلّ قارئ من السّبعة و غيرهم منقسمة إلى المجمع عليه و الشّاذّ، غير أن هؤلاء السّبعة لشهرتهم و كثرة الصّحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النّفس إلى ما ينقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم.
ثم قال ابن الجزريّ: و قولنا في الضّابط (و لو بوجه) نريد به وجها من وجوه النّحو سواء كان أفصح أو فصيحا مجمعا عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضرّ مثله إذا كانت القراءة ممّا شاع و ذاع و تلقاه الأئمّة بالإسناد الصّحيح إذ هو الأصل الأعظم و الركن الأقوم، و كم من قراءة أنكرها بعض أهل النّحو أو كثير منهم و لم يعتبر إنكارهم كإسكان: بارِئِكُمْ [ (2) البقرة: 54] وَ يَأْمُرُكُمْ [ (2) البقرة: 67] و خفض: وَ الْأَرْحامَ [ (4) النساء: 1] و نصب:
لِيَجْزِيَ قَوْماً [ (45) الجاثية: 14] و الفصل بين المضافين في الأنعام و غير ذلك.
قال الدّاني و أئمة القرّاء: لا يعمل في شي ء من حروف القرآن على الأفشى في اللّغة و الأقيس في العربيّة بل على الأثبت في الأثر و الأصحّ في النّقل، و إذا ثبتت الرّواية لم يردّها قياس عريبة و لا فشوّ لغة لأن القراءة سنّة متّبعة يلتزم قبولها و المصير إليها ثم قال:
ص: 66
و نعني بموافقة أحد المصاحف: ما كان ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة بن عامر: قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً [ (2) البقرة: 116]، في البقرة بغير واو، وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتابِ الْمُنِيرِ [ (3) آل عمران: 184]، بالباء فيهما فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، و كقراءة ابن كثير:
(تجري من تحتها الأنهار) [ (9) التوبة: 100]، في آخر براءة بزيادة «من» فإنه ثابت في المصحف المكي و نحو ذلك، فإن لم تكن في شي ء من المصاحف العثمانية فشاذة لمخالفتها الرّسم المجمع عليه.
و قولنا: و لو احتمالا، لا نعني به: ما وافقه و لو تقديرا كملك يوم الدّين فإنه كتب في الجميع بلا ألف، فقراءة الحذف توافقه تحقيقا، و قراءة الألف توافقه تقديرا لحذفها في الخطّ اختصارا، كما كتب (ملك الملك) [ (3) آل عمران: 26]، و قد يوافق اختلاف القراءات الرّسم تحقيقا نحو: (تعملون) بالتاء و الياء، و يَغْفِرْ لَكُمْ بالياء و النون و نحو ذلك مما يدلّ تجرّده عن النّقط و الشكل في حذفه و إثباته على فضل عظيم للصّحابة في علم الهجاء خاصة و فهم ثاقب في تحقيق كلّ علم.
و انظر كيف كتبوا: الصِّراطَ بالصّاد المبدلة من السّين، و عدلوا عن السّين التي هي الأصل ليكون قراءة السّين و إن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان، و تكون قراءة الإشمام محتملة، و لو كتب ذلك بالسّين على الأصل لفات ذلك و عدّت قراءة غير السّين مخالفة للرّسم و الأصل، و لذلك اختلف في رسم بَصْطَةً [ (7) الأعراف: 69]، دون بَسْطَةً [ (2) البقرة: 247]، لكون حرف البقرة كتب بالسّين و الأعراف بالصّاد، على أن مخالف صريح الرّسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعدّ مخالفا إذا ثبتت القراءة به و وردت مشهورة مستفاضة، و لذا لم يعدّوا إثبات ياء الزّوائد، و حذف تاء فَلا تَسْئَلْنِي [ (13) الكهف: 70] و واو: وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ [ (63) المنافقون:
10] و الظّاء من: بِضَنِينٍ [ (81) التكوير: 24] و نحوه من مخالفة الرّسم المردودة، فإن الخلاف في ذلك مغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد، و تمشّيه صحة القراءة و شهرتها و تلقّيها بالقبول زيادة كلمة و نقصانها و تقديمها و تأخيرها حتّى و لو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني فإنّ حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرّسم فيه، و هذا هو الحدّ الفاصل في حقيقة اتّباع الرّسم و مخالفته.
قال: و قولنا: و صحّ سندها، يعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضّابط عن مثله كذا حتّى تنتهي و تكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أو ممّا شذّ بها بعضهم قال: و قد شرط بعض المتأخّرين التّواتر في هذا الركن و لم يكتف
ص: 67
بصحّة السّند و زعم أن القرآن لا يثبت إلّا بالتّواتر و أن ما جاء مجي ء الآحاد لا يثبت به قرآن قال: و هذا ممّا لا يخفى ما فيه فإن التّواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرّسم و غيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم وجب قبوله و قطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم لا و إذا شرطنا التّواتر في كلّ حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثّابت عن السّبعة.
قال أبو شامة: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين و غيرهم من المقلّدين أن السبع كلّها متواترة أي كلّ فرد فرد ممّا روي عنهم، قالوا: و القطع بأنّها منزّلة من عند اللّه واجب و نحن بهذا نقول، و لكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطّرق و اتّفقت عليه الفرق من غير نكير له فلا أقلّ من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها.
و قال الجعبري: الشّرط واحد، و هو صحّة النقل و يلزم الآخران فمن أحكم معرفة حال النقلة و أمعن في العربيّة و أتقن الرّسم انجلت له هذه الشبهة.
و قال مكّي: ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به و يكفر جاحده، و هو ما نقله الثّقات و وافق العربيّة و خطّ المصحف، و قسم صحّ نقله عن الآحاد و صح في العربية و خالف لفظه الخطّ فيقبل و لا يقرأ به لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه و أنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر الآحاد و لا يثبت به قرآن و لا يكفر جاحده و بئس ما صنع إذا جحده، و قسم نقله ثقة و لا وجه له في العربية أو نقله غير ثقة فلا يقبل و إن وافق الخط.
قال ابن الجزريّ: مثال الأول كثير كقراءة: (مالك و ملك)، و (يخدعون و يخادعون) و مثال الثاني: قراءة ابن مسعود و غيره: الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى [ (92) الليل: 3]، و قراءة ابن عباس: (و كان أمامهم ملك يأخذ كلّ سفينة صالحة) [ (18) الكهف: 79] و نحو ذلك.
قال: و اختلف العلماء في القراءة بذلك في الصّلاة، و الأكثر على المنع لأنّها لم تتواتر و لم تثبت بالنقل فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصّحابة على المصحف العثماني، و مثال ما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذّ مما غالب إسناده ضعيف، و كالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي و نقلها عنه أبو القاسم الهذلي و منها: إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ [ (35) فاطر: 28]، برفع اللّه و نصب العلماء، و قد كتب الدّار قطني و جماعة بأن هذا الكتاب موضوع لا أصل له، و الدار قطني المذكور هو الحافظ أبو الحسن المشهور كان من أئمة المقرئين أيضا.
و مثال ما نقله ثقة و لا وجه له في العربية قليل لا يكاد يوجد، و جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع مَعايِشَ [ (7) الأعراف: 10] بالهمز.
ص: 68
قال: و بقي قسم رابع مردود أيضا، و هو ما وافق العربية و الرّسم و لم ينقل البتة فهذا ردّه أحقّ و منعه أشدّ و مرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، و قد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر ابن مقسم و عقد له بسبب ذلك مجلس و أجمعوا على منعه و من ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق الذي لا أصل له يرجع إليه و لا ركن وثيق يعتمد في الأداء عليه، قال: أمّا ما له أصل كذلك فإنّه مما يصار إلى قبول القياس عليه كقياس: إدغام: قالَ رَجُلانِ [ (5) المائدة: 23] على: قالَ رَبِّ [ (21) الأنبياء: 112] و نحوه مما لا يخالف نصّا و لا أصلا و لا يردّ إجماعا مع أنه قليل جدا.
قلت: قد أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدا، و قد تحرر لي منه أن روايات القرآن على أنواع:
الأول: المتواتر: و هو ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه.
الثّاني: الآحاد الذي فقد فيه التّواتر، و هو ما صحّ سنده و وافق العربيّة و الرّسم و اشتهر عند القرّاء فلم يعدّوه من الغلط و لا من الشّذوذ و يقرأ به على ما قال ابن الجزري و الشّرط الأخير و إن لم يذكره في أول كلامه فقد ذكره في آخر الكلام على الضّابط و لا بد منه فيتفطّن له.
الثالث: الشّاذّ: و هو ما صحّ سنده و خالف الرّسم و العربية مخالفة تضرّ أو لم تشتهر عند القرّاء و لا يقرأ به.
الرابع: المنكر أو الغريب و هو ما لم يصحّ سنده.
الخامس: الموضوع و هو أحطّ من الذي قبله كالتي جمعها الخزاعي. و هذا تقسيم حسن يوافق مصطلح الحديث، و لم أسمّ القسمين الآخرين بالشاذّ تبعا للمحدّثين إذ الشّاذّ عندهم ما صحّ سنده و خولف فيه الملأ، فما لم يصحّ سنده لا يسمّى شاذّا بل ضعيفا أو منكرا على حسب حاله، و القرّاء لا يمتنعون من إطلاق الشّذوذ على ذلك و ما صنعته أقرب.
و قد ظهر لي قسم آخر يشبهه من أنواع الحديث المدرج و هو: ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة ابن مسعود: (و له أخ أو أخت من أمّ) [ (4) النساء: 12].
ص: 69
قال ابن الجزريّ: و ربّما كانوا يدخلون التّفسير في القراءة إيضاحا و بيانا لأنهم محققون لما تلقّوه عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قرآنا فهم آمنون من الالتباس و ربّما كان بعضهم يكتبه معه، و أما من يقول: إن بعض الصّحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب انتهى، فهذه ستة أنواع. و إن كنا ترجمناها أول الباب ثلاثة حرّرتها بعد التعب الشديد و إن كان في ألفاظ القرّاء استعمال أسماء غير الأخير منها.
الأول: قال ابن الحاجب: السّبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمدّ و الإمالة و تخفيف الهمزة، قال ابن الجزريّ: و قد وهم في ذلك، هل حال اللّفظ و الأداء واحد، و إذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى إذ اللّفظ لا يقوم إلّا به و لا يصحّ إلّا بوجوده و نصّ على تواتر ذلك كلّه القاضي أبو بكر الباقلاني و غيره، قال: و لا نعلم أحدا تقدّم ابن الحاجب إلى ذلك، و تقدّم في كلام البلقيني أن أصل الإمالة و المدّ و نحوهما متواتر لا كيفيته، فهو يصلح أن يكون موافقا لابن الحاجب و أن يكون متوسطا بينه و بين إطلاق الجمهور.
الثّاني: الذي نقطع به و تقوم عليه الحجج و الدلائل و البراهين و لا ينبغي لآدمي أن يمتري فيه أن البسملة متواترة أول كلّ سورة نقلها الجمع البالغون حدّ التواتر عن مثلهم إلى النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم، بل الأحاديث الواردة بقراءتها أول الفاتحة و أوّل كلّ سورة في الصّلاة و خارجها بلغت عندي مبلغ التّواتر، فقد رواه عن النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم أنس في حديث نزول الكوثر و عمر، و عثمان، و عليّ، و أبو هريرة، و ابن عباس و عمار بن ياسر و جابر بن عبد اللّه، و النعمان ابن بشير، و الحكم بن عمير، و سمرة بن جندب و أبيّ بن كعب، و بريدة، و مجالد بن ثور، و بشر أو بسر بن معاوية و حسين بن عرفطة، و عائشة، و أمّ سلمة، و أمّ هانئ، و جماعة آخرون، و قد أفردت أحاديثهم في جزء.
الثالث: وقع لنا سورتان تردّدت في كونهما من الشاذّ أو المنسوخ، روى البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع و فيه فقال: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. اللّهمّ إنّا نستعينك و نستهديك و نستغفرك و نثني عليك و لا نكفرك، و نخلع و نترك من يفجرك، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، اللّهمّ إيّاك نعبد، و لك نصلّي و نسجد، و إليك نسعى و نحفد، نرجو رحمتك، و نخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق.
ص: 70
قال ابن جريج في حكمة البسملة: إنهما سورتان في مصحف بعض الصّحابة و روى محمد بن نصر عن أبيّ بن كعب أنه كان يقنت بالسّورتين فذكرهما. و روى الطّبراني في الدعاء من طريق عبّاد بن يعقوب الأسدي عن يحيي بن يعلى الأسلمي عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن عبد اللّه بن زرير الغافقي قال: قال لي عبد الملك بن مروان: لقد علمت ما حملك على حبّ أبي تراب إلّا أنك أعرابيّ جاف فقلت: و اللّه لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبواك و لقد علّمني منه علي بن أبي طالب سورتين علّمهما إياه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ما علمتهما أنت و لا أبوك فذكرهما.
و روى أبو داود في المراسيل بسند رجاله موثقون لكنه مرسل أنه صلّى اللّه عليه و سلّم بينا هو يدعو على نفر في الصّلاة إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكت ثم قال: يا محمّد إن اللّه لم يبعثك لعّانا و لا سبّابا و لم يبعثك عذابا و إنما بعثك رحمة لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ [ (3) آل عمران: 128] ثم علّمه القنوت فذكرهما.
و قال أبو عبيد: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: كتب أبيّ ابن كعب في مصحفه: فاتحة الكتاب و المعوذتين و اللهمّ إنا نستعينك، و اللهمّ إياك نعبد و تركهنّ ابن مسعود، و كتب عثمان منهن: فاتحة الكتاب و المعوذتين. و هذا الذي نسبه إلى ابن مسعود قد روي عنه من طريق أخرى، فروى البزّار من طريق حسّان بن إبراهيم عن الصلت بن بهرام عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف و يقول: إنما أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم أن يتعوذ بهما و كان عبد اللّه لا يقرأ بهما. و رواه أيضا ابن حبّان في صحيحه، و أجاب ابن قتيبة في مشكل القرآن عن هذا بأنه ظن أنهما ليستا من القرآن لأنه رأى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم يعوّذ بهما الحسن و الحسين فأقام على ظنه، و لا نقول إنه أصاب في ذلك و أخطأ المهاجرون و الأنصار.
قال: و أما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآن معاذ اللّه، و لكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كتب و جمع بين اللوحين مخافة الشّكّ و النّسيان و الزّيادة و النّقصان، و رأى أن ذلك مأمون في سورة الحمد لقصرها و وجوب تعلّمها على كلّ أحد.
و قال النّووي: لا يصح إسقاط المعوّذتين عن ابن مسعود لأن قراءة بعض السبعة من طريقه و فيها المعوّذتان.
ص: 71
عقد له الحاكم و الترمذي بابا، و ذكر البلقيني منه أشياء، و أخرج الحاكم من طريق عبد اللّه بن أبي مليكة عن أمّ سلمة قالت: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يقطّع قراءته: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ثم يقف و أخرج من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و سلّم كان يقرأ: (ملك يوم الدّين).
و أخرج من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قرأ: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ بالصاد.
و أخرج من طريق خارجة أيضا قال: أقرأني زيد قال: أقرأني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم (فرهن مقبوضة) [ (2) البقرة: 283] بغير ألف.
و أخرج من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قرأ:
وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ [ (3) آل عمران: 161] بفتح الياء.
و أخرج من طريق الزهري عن أنس أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم كان يقرأ: وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [ (5) المائدة: 45] بالرفع.
و أخرج من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: سألت معاذ بن جبل عن قول الحواريّين: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أو (هل تّستطيع ربك) [ (5) المائدة: 112]. قال: أقرأني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: (هل تستطيع) بالتاء.
و أخرج من طريق عبد اللّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قرأ: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ [ (9) التوبة: 128] يعني من أعظمكم قدرا.
و أخرج من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم كان يقرأ: (و كان أمامهم ملك يأخذ كلّ سفينة صالحة غصبا) [ (18) الكهف: 79].
و أخرج من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: إنّي أنا الرّزّاق ذو القوة المتين.
و أخرج من طريق أبي الزّبير عن جابر قال: قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [ (88) الغاشية: 22] بالصاد.
ص: 72
و أخرج من طريق نافع عن ابن عمر قال: ما همز رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و لا أبو بكر و لا الخلفاء و إنما الهمز بدعة ابتدعها من بعدهم يعني في النّبيّ ثم قال: حدّثني أحمد بن العبّاس المقرئ حدّثنا البغويّ حدّثنا خلف بن هشام قال: حدّثني الكسائي حدّثني حسين الجعفي عن حمران بن أعين عن أبي الأسود الدّؤلي عن أبي ذرّ قال: جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: يا نبي ء اللّه، فقال: لست بنبي ء اللّه، و لكنّني نبيّ اللّه، و قال: صحيح على شرط الشّيخين، و شاهده ما تقدّم.
قلت: بل هو منكر لم يصح و حمران ليس بثقة، و لو صحّ لم نعارش ما ثبت بالتّواتر و النّقل المستفيض المشهور.
أشهر قرّاء القرآن من الصحابة: عثمان، و علي، و أبيّ، و زيد بن ثابت، و ابن مسعود، و أبو الدرداء، و في الصحيح من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص سمعت النبي صلّى اللّه عليه و سلّم يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد اللّه بن مسعود و سالم و معاذ و أبيّ بن كعب».
و فيه عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم؟
فقال: أربعة كلهم من الأنصار: أبيّ بن كعب، و معاذ بن جبل، و زيد بن ثابت، و أبو زيد.
و فيه عن أنس أيضا قال: مات النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و لم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدّرداء، و معاذ بن جبل، و زيد بن ثابت و أبو زيد.
قال البلقيني: فيكون الحفّاظ بمقتضى الروايتين خمسة، و المراد بذلك من الأنصار و إلّا فقد حفظه على عهده عليه الصّلاة و السّلام من غير الأنصار: عثمان و سالم و ابن مسعود، فهؤلاء ثمانية.
قلت: بل جمعه في عهده عليه الصلاة و السلام غيرهم أيضا، فمنهم عبد اللّه بن عمرو بن العاص فقد قال: جمعت القرآن فقرأت به كلّ ليلة فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم.
الحديث، و أبو الدّرداء- قال ابن كثير: و أبو بكر الصّديق- فقد قدّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم إماما على المهاجرين و الأنصار مع أنه قال: «يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب اللّه» فلو لا أنه كان أقرأهم لكتاب اللّه لما قدّمه عليهم.
قلت: و أيضا فهو أوّل الناس إسلاما فكيف يجمعه من أسلم بعده بدهر و لا يجمعه
ص: 73
هو، و هو هو، و سالم، و هو مولى أبي حذيفة، و أبو زيد: أحد عمومة أنس، و اختلف في اسمه فقيل: لا يعرف، و قيل: ثابت بن زيد، و قيل: معاذ، و قيل: أوس، و قيل: قيس ابن السّكن و هو المشهور و هو خزرجيّ؛ و قيل: هو من الأوس و اسمه: سعيد بن عبيد بن النعمان، و قيل: هما اثنان جمعا القرآن ثم أخذ عن هؤلاء الصّحابة: أبو هريرة، و ابن عباس، و عبد اللّه بن السّائب عن أبيّ، و أخذ ابن عباس عن زيد أيضا، و أخذ عنهم خلق من التّابعين؛ فممّن كان بالمدينة: ابن المسيّب، و عروة، و سالم، و عمر بن عبد العزيز، و سليمان و عطاء ابنا يسار، و معاذ بن الحارث المشهور بمعاذ القارئ، و عبد الرحمن بن هرمز الأعوج، و ابن شهاب الزّهري، و مسلم بن جندب، و زيد بن أسلم.
و بمكة: عبيد بن عمير، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و عكرمة، و ابن أبي مليكة.
و بالكوفة: علقمة، و الأسود، و مسروق، و عبيدة، و عمرو بن شرحبيل، و الحارث بن قيس، و الرّبيع بن خيثم، و عمرو بن ميمون، و أبو عبد الرحمن السلمي، و زرّ بن حبيش، و عبيد بن فضيلة، و سعيد ابن جبير، و النّخعي، و الشعبي.
و بالبصرة: أبو العالية، و أبو رجاء، و نصر بن عاصم، و يحيى بن يعمر، و الحسن، و ابن سيرين، و قتادة.
و بالشام: المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان و خليد بن سعيد صاحب أبي الدّرداء.
ثم تجرّد قوم و اعتنوا بضبط القرآن أتمّ عناية حتّى صاروا أئمة يقتدى بهم و يرحل إليهم. فكان بالمدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ثم شيبة بن نصاح، ثم نافع بن أبي نعيم، و بمكة: عبد اللّه بن كثير، و حميد بن قيس الأعرج، و محمد بن محيصن.
و بالكوفة: يحيى بن وثاب، و عاصم بن أي النجود، و سليمان الأعمش، ثم حمزة، ثم الكسائي. و بالبصرة: عبد اللّه بن أبي إسحاق، و عيسى بن عمر، و أبو عمرو بن العلاء، و قيس بن عاصم الجحدري، ثم يعقوب الحضرمي.
و بالشام: عبد اللّه بن عامر، و عطية بن قيس الكلابي، و إسماعيل بن عبد اللّه بن المهاجر، ثم يحيى بن الحارث الذماري، ثم شريح بن يزيد الحضرمي.
و اشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة: نافع، و أخذ عن سبعين من التابعين منهم أبو جعفر، و ابن كثير، و أخذ عن عبد اللّه بن السائب الصحابي؛ أبو عمرو، و أخذ عن التابعين، و ابن عامر و أخذ عن أبي الدّرداء، و أصحاب عثمان؛ و عاصم، و أخذ عن التابعين، و حمزة، و أخذ عن عاصم، و الأعمش، و السبيعي، و منصور بن المعتمر و غيرهم؛ و الكسائي، و أخذ عن حمزة، و أبي بكر بن عيّاش.
ص: 74
ثم انتشر القرّاء في الأقطار و تفرّقوا أمما [بعد أمم] و اشتهر من رواه كل طريق من السّبعة راويان، فعن نافع: قالون، و ورش عنه؛ و عن ابن كثير: قنبل، و البزّي عن أصحابهما عنه؛ و عن أبي عمرو: الدّوري، و السوسي عن اليزيدي عنه؛ و عن ابن عامر:
هشام، و ابن ذكوان عن أصحابهما عنه؛ و عن الكسائي: الدّوري، و أبو الحارث.
ثم لمّا اتّسع الخرق و كاد الباطل أن يلتبس بالحق قام جهابذة الأمة و بالغوا في الاجتهاد و جمعوا الحروف و القراءات و عزوا الوجوه و الروايات، و ميّزوا الصحيح و المشهور و الشاذ بأصول أصّلوها، و أركان فصّلوها، و أوّل من صنّف في القراءات: أبو عبيد القاسم ابن سلّام، ثم أحمد بن جبير بن محمد الكوفي، ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون، ثم أبو جعفر بن جرير الطّبري، ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني، ثم أبو بكر بن مجاهد. ثم قام الناس في هذا العصر و بعده بالتأليف في أنواعها جامعا و مفردا و موجزا و مسهبا، و أئمة المقرئين لا تحصى، و قد صنّف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد اللّه الذّهبي، ثم حافظ القرّاء: أبو الخير بن الجزري و لا مزيد على كتابيهما.
هذا النوع من زيادتي، و هو مهمّ و أوجه التّحمّل عند المحدّثين ثمانية: السّماع من لفظ الشيخ و القراءة عليه و السّماع عليه بقراءة غيره، و المناولة، و الإجازة و المكاتبة، و الوصية، و الإعلام.
فأما غير الأوّلين فلا يأتي هنا كما ستعلم مما نذكره، و أما القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلفا و خلفا، و أما السّماع من لفظ الشّيخ فقد كنت أقول به هنا لأن الصحابة رضي اللّه عنهم إنما أخذوا القرآن من في رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، لكن لم يأخذ به أحد من القرّاء و هو ظاهر من جهة أن المقصود هنا كيفيّة الأداء، و ليس كلّ من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته بخلاف الحديث، فإن المقصود المعنى أو اللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن، و أما الصحابة فكانت فصاحتهم و طباعهم السّليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي صلّى اللّه عليه و سلّم.
و يحكى أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لمّا قدم القاهرة و ازدحمت عليه الخلق لم يتسع وقته لقراءة الجميع، فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة، فلم يكتف بقراءته.
ص: 75
و تجوز القراءة على الشيخ و لو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة إذا كان بحيث لا يخفى عليه حالهم، و قد كان الشيخ علم الدين السّخاوي يقرأ عليه اثنان و ثلاثة في أماكن مختلفة و يردّ على كلّ منهم، و كذا لو كان الشّيخ مشتغلا بشغل آخر كنسخ و مطالعة و أما القراءة من الحفظ فالظاهر أنها ليست بشرط بل تكفي و لو من المصحف.
إعطاء كلّ حرف حقّه من إشباع المدّ و تحقيق الهمز و إتمام الحركات و اعتماد الإظهار و التشديدات و بيان الحروف و تفكيكها و إخراج بعضها من بعض مع التّرسّل و التّؤدة بلا قصر و لا اختلاس و لا إسكان متحرّك و لا إدغامه، و يستحبّ الأخذ به على المتعلّمين من غير مجاوزة إلى حدّ الإفراط بتوليد الحروف من الحركات و تكرير الرّاءات و تحريك السّواكن و الفصل بين حروف الكلمة كما يقف كثير من الجهّال على التّاء من (نستعين) وقفة لطيفة مدّعيا أنه يرتّل.
إدراج القراءة و سرعتها و تخفيفها بالقصر و التسكين و الاختلاس و البدل و الإدغام الكبير و تخفيف الهمزة بالقصر و التسكين و نحو ذلك مما صحت به الرواية بدون بتر حروف المدّ و اختلاس أكثر الحركات و التفريط إلى غاية لا تصحّ بها القراءة و لا توصف بها التّلاوة، و هذا النّوع مذهب ابن كثير و أبي جعفر، و من قصر المنفصل كأبي عمرو و يعقوب.
و هو التّوسط بين المقامين و هو المختار عند أكثر أهل الأداء- و اختلف في الأفضل هل الترتيل و قلّة القراءة أو السّرعة و كثرتها؟ و معظم السّلف و الخلف على الأوّل، و توسّط بعضهم فقال: ثواب الكثيرة أكثر عددا، و ثواب التّرتّل أقلّ قدرا.
و أما كيفيّة الأخذ بإفراد القراءات و جمعها فالّذي كان عليه السّلف أخذ كلّ ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها إلى أثناء المائة الخامسة فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة و استقرّ عليه العمل و لم يكونوا يسمحون به إلّا لمن أفرد القراءات و أتقن طرقها و قرأ قارئ بختمة على حدة، بل إذا كان للشّيخ راويان قرءوا لكلّ راو بختمة، ثم يجمعون له و هكذا، و تساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكلّ قارئ من السبعة بختمة سوى نافع و حمزة، فإنهم كانوا يأخذون بختمة لقالون، ثم بختمة لورش، ثم بختمة لخلف، ثمّ بختمة لخلاد، و لا يسمح أحد بالجمع إلّا بعد ذلك، نعم إذا رأوا شخصا أفرد و جمع على شيخ معتبر و أجيز و تأهّل و أراد أن يجمع القراءات في ختمة لا يكلّفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حدّ المعرفة و الإتقان.
ص: 76
ثم لهم في الجمع مذهبان:
أحدهما الجمع بالحرف بأن يشرع في القراءة، فإذا مرّ بكلمة فيها خلف أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها، ثم يقف عليها إن صلحت للوقف، و إلّا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف، و إن كان الخلف يتعلّق بكلمتين كالمدّ المنفصل، وقف على الثّانية و استوعب الخلاف و انتقل إلى ما بعدها و هذا مذهب المصريّين و هو أوثق في الاستيفاء و أخفّ على الأخذ لكنّه يخرج عن رونق القراءة و حسن التلاوة.
الثّاني: الجمع بالوقف بأن يشرع بقراءة من قدّمه حتّى ينتهي إلى وقف، ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف ثمّ يعود و هكذا حتى يفرغ. و هذا مذهب الشاميين و هو أشدّ استحضارا و أشدّ استظهارا و أطول زمانا و أجود مكانا، و كان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرّسم و أما ترتيب القراءات فليس بشرط و لكن يستحبّ أن يبدأ بما بدأ به المؤلّفون في كتبهم فيبدأ بالقصر، ثم بالمرتبة التي فوقه و هكذا إلى آخر مراتب المدّ.
و يبدأ بالمشبع ثم بما دونه إلى القصر، و إنما يسلك ذلك مع شيخ بارع عظيم الاستحضار، أما غيره فيسلك معه ترتيب واحد، و إذا انتقل القارئ إلى قراءة قبل إتمام ما قبلها لم يدعه الشّيخ بل يشير إليه بيده، فإن لم يتفطّن قال له: لم تصل فإن لم يتفطّن سكت حتّى يتذكره، فإن عجز قاله له.
و أما القراءة بالتّلفيق و خلط قراءة بأخرى فأجازها أكثر القرّاء و منعها قوم، و قال ابن الصّلاح و النّووي: ينبغي أن يداوم على قراءة واحدة حتّى ينقضي ارتباط الكلام فإذا انقضى فله الانتقال إلى قراءة أخرى، و الأولى المداومة على تلك القراءة في ذلك المجلس قال ابن الجزريّ: و الصّواب التّفصيل، فإن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى منع ذلك منع تحريم كمن يقرأ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ [ (2) البقرة: 37] برفعهما أو نصبهما، آخذا رفع «آدم» من قراءة غير ابن كثير، و رفع «كلمات» من قراءته و نحو ذلك مما لا يجوز في العربية و اللّغة، و ما لم يكن كذلك فرّق فيه بين مقامن الرّواية و غيرها، فإن كان على سبيل الرّواية حرم أيضا لأنه كذب في الرّواية و تخليط، و إن كان على سبيل القراءة و التّلاوة جاز.
و أما القراءات و الرّوايات و الطّرق و الأوجه و سيأتي في النوع الآتي بيانها فليس للقارئ أن يدع منها شيئا أو يخلّ به، فإنه خلل في إكمال الرّواية إلّا الأوجه فإنها على سبيل التخيير، فأيّ وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية.
ص: 77
و أما قدر ما يقرأ حال الأخذ فقد كان الصّدر الأوّل لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان، و أما من بعدهم فرأوه بحسب قوّة الأخذ. قال ابن الجزري: و الّذي استقرّ عليه العمل: الأخذ في الإفراد بجزء من أجزاء مائة و عشرين، و في الجمع بجزء من أجزاء مائتين و أربعين. و لم يحدّ له آخرون حدّا، و هو اختيار السّخاوي، و قد لخصت هذا النوع و رتّبت فيه متفرّقات كلام أئمة القراءات و هو نوع مهمّ يحتاج إليه القارئ كاحتياج المحدّث إلى مثله من علم الحديث.
ادّعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثا عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم ما لم يكن له به رواية و لو بالإجازة فهل يكون حكم القرآن كذلك فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأ بها ما لم يقرأها على شيخ. لم أر في ذلك نقلا و لذلك وجه من حيث إن الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشدّ منه في ألفاظ الحديث و لعدم اشتراطة أيضا وجه من حيث إن اشتراط ذلك في الحديث إنما هو لخوف أن يدخل في الحديث ما ليس منه أو يتقوّل على النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم ما لم يقله، و القرآن محفوظ متلقّى متداول ميسّر و لا يخلو هذا المحلّ من نظر و تأمّل، و لا يشفي فيه إلّا نقل معتمد.
هذا النّوع من زيادتي و هو أيضا مهمّ فإن علوّ الإسناد سنّة و قربة إلى اللّه تعالى، و قد قسّمه أهل الحديث إلى خمسة أقسام تأتي هنا.
الأوّل: القرب من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم من حيث العدد بإسناد نظيف غير ضعيف و هو أفضل أنواع العلوّ و أجلّها، و أعلى ما يقع للشّيوخ في هذا الزمان إسناد رجاله أربعة عشر رجلا، و إنما يقع ذلك من قراءة ابن عامر من رواية ذكوان، ثم خمسة عشر، و إنما يقع ذلك من قراءة عاصم من رواية حفص و قراءة يعقوب من رواية رويس.
الثّاني: من أقسام العلوّ عند المحدّثين: القرب إلى إمام من أئمة الحديث كالأعمش، و هشيم، و ابن جريج، و الأوزاعي، و مالك، و نظيره هنا: القرب إلى إمام من الأئمة السّبعة، فأعلى ما يقع اليوم للشيوخ بالإسناد المتّصل بالتلاوة إلى نافع: اثنا عشر و إلى ابن عامر: اثنا عشر.
الثّالث: عند المحدّثين: العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة بأن يروي حديثا لو رواه من طريق كتاب من السّتة وقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها. و نظيرها هنا العلوّ بالنسبة إلى بعض الكتب المشهورة في القراءات كالتّيسير و الشاطبية.
ص: 78
و يقع في هذا النّوع: الموافقات، و الإبدال، و المساواة و المصافحات فالموافقة: أن يجتمع طريقه مع أحد أصحاب الكتب في شيخه، و قد يكون مع علوّ على ما لو رواه من طريقه أو لا يكون، مثله في هذا الفنّ قراءة ابن كثير رواية البزّي طريق ابن بنان عن أبي ربيعة عنه يرويها ابن الجزري من كتاب المفتاح لأبي منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون و من كتاب المصباح لأبي الكرم الشّهرزوري، و قرأ به كلّ من المذكورين على عبد السيد بن عتاب فروايته لها من أحد الطريقين تسمى موافقة للآخر باصطلاح أهل الحديث.
و البدل: أن يجتمع معه في شيخ شيخه فصاعدا، و قد يكون أيضا بعلو و قد لا يكون، مثاله هنا قراءة أبي عمرو رواية الدّوريّ طريق ابن مجاهد عن أبي الزّعراء عنه رواها ابن الجزري من كتاب التّيسير، قرأ بها الدّاني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادي و قرأ بها على أبي طاهر عن ابن مجاهد، و من المصباح قرأ بها أبو الكرم على أبي القاسم يحيى بن أحمد بن السّيبي و قرأ بها علي بن الحسن الحمّامي، و قرأ على أبي طاهر فروايته لها من طريق المصباح يسمّى بدلا للدّاني في شيخ شيخه.
و المساواة: أن يكون بين الرّاوي و النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم أو الصّحابي أو من دونه إلى شيخ أحد أصحاب الكتب كما بين أحد أصحاب الكتب و النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم أو الصّحابي أو من دونه على ما ذكر من العدد.
و المصافحة: أن يكون أكثر عددا منه بواحد فكأنه لقي صاحب ذلك الكتاب و صافحه و أخذ عنه، مثاله قراءة نافع رواها الشّاطبيّ عن أبي عبد اللّه محمد بن علي النفري عن أبي عبد اللّه بن غلام الفرس عن سليمان بن نجاح و غيره عن أبي عمرو الدّاني عن أبي الفتح فارس بن أحمد عن عبد الباقي بن الحسن عن إبراهيم بن عمر المقرئ عن أبي الحسين بن بويان عن أبي بكر بن الأشعث عن أبي جعفر الربعي المعروف بأبي نشيط عن قالون عن نافع و رواها ابن الجزري عن أبي محمد بن البغدادي و غيره عن الصائغ عن الكمال بن فارس عن أبي اليمن الكندي عن أبي القاسم هبة اللّه بن أحمد الحريري عن أبي بكر الخياط عن الفرضي عن ابن بويان، فهذه مساواة لابن الجزري لأن بينه و بين ابن بويان سبعة و هو العدد الذي بين الشاطبي و بينه، و هي لمن أخذ عن ابن الجزري مصافحة للشاطبي.
و مما يشبه هذا التّقسيم لأهل الحديث تقسيم القرّاء أحوال الإسناد إلى: قراءة، و رواية، و طريق، و وجه. فالخلاف إن كان لأحد الأئمّة السّبعة أو العشرة أو نحوهم و اتفقت عليه الرّوايات و الطّرق عنه فهو قراءة، و إن كان للراوي عنه فرواية، أو لمن بعده فنازلا فطريق، أو لا على هذه الصّفة ممّا هو راجع إلى تخيير القارئ فوجه.
ص: 79
الرّابع: من أقسام العلوّ: تقدّم وفاة الشّيخ عن قرينه الّذي أخذ عن شيخه، فالأخذ مثلا عن التّاج بن مكتوم أعلى من الأخذ عن أبي المعالي بن اللّبان و عن ابن اللبان أعلى من البرهان الشّامي و إن اشتركوا في الأخذ عن أبي حيّان لتقدم وفاة الأوّل على الثّاني و الثّاني على الثالث.
الخامس: العلوّ بموت الشّيخ مع التفات إلى أثر آخر، أو شيخ آخر متى يكون، قال بعض المحدّثين: يوصف الإسناد بالعلوّ إذا مضى عليه من موت الشّيخ خمسون سنة، و قال ابن منده: ثلاثون فعلى هذا الأخذ عن أصحاب ابن الجزري عال من سنة ثلاث و ستين و ثمانمائة، لأن ابن الجزري آخر من كان سنده عاليا، و قد مضى عليه حينئذ من موته ثلاثون سنة، فهذا ما حرّرته من قواعد الحديث و فرعت عليه فواعد القراءات و للّه المنّة و الحمد.
و إذا عرفت العلوّ بأقسامه عرفت النّزول فإنّه ضدّه، و حيث ذمّ النّزول فهو ما لم ينجبر لكون رجاله أعلم أو أتقن أو أجلّ أو أشهر أو أورع، أما إذا كان كذلك فليس بمذموم و لا مفضول، و العالي: ما صحّ إسناده و لو بلغت رواته مائة.
هذا النوع من زيادتي. و المسلسل: ما تواردت رواته على صفة أو كيفيّة واحدة، و قسّمه أهل الحديث إلى أقسام لا يأتي غالبها هنا و منه، ما تسلسل في أوّله و انقطع لو اعتنى القرّاء به كاعتناء المحدّثين لاتّصل لهم من ذلك شي ء كثير. و أكثر ما يقع التّسلسل هنا بصفات الرّواة كالتّسلسل بالقرّاء الحفّاظ، و القرآن كلّه بهذه الصّفة، نقله قارئ عن قارئ إلى منتهاه، و كأن يكون رجال الإسناد كلّهم معمّرين أو شافعيّين أو أندلسيين أو دمشقيين أو مكيين أو نحو ذلك، و قد وقعت لنا سورة الصّفّ مسلسلة بقراءة كلّ شيخ على الرّاوي.
و أخبرني المسند المعمّر أبو عبيد اللّه محمد بن أحمد الحاكم رحمه اللّه بقراءتي عليه، أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد المقرئ أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الصّالحي أخبرنا أبو المنجا بن اللّتي أخبرنا أبو الوقت السجزي أخبرنا أبو الحسن الدّاودي أخبرنا أبو محمد السرخسي أخبرنا أبو عمران السّمرقندي أخبرنا أبو محمد الدّارمي أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد اللّه بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول صلّى اللّه عليه و سلّم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبّ إلى اللّه عز و جل لعملناه فأنزل اللّه: سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ [ (61) الصف: 1، 3] حتى ختمها.
ص: 80
قال عبد اللّه فقرأها علينا ابن سلام قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة، قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى، قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي، قال الدارمي: فقرأها علينا ابن كثير، قال السّمرقندي: فقرأها علينا الدّارمي، قال السّرخسي: فقرأها علينا السّمرقندي، قال الدّاودي: فقرأها علينا السّرخسي: قال أبو الوقت: فقرأها علينا الدّاودي، قال ابن اللّتي: فقرأها علينا أبو الوقت، قال أبو العباس فقرأها علينا ابن اللّتي، قال أبو إسحاق فقرأها علينا أبو العباس قال أبو عبد اللّه: فقرأها علينا أبو إسحاق، قلت: فقرأها علينا أبو عبد اللّه.
و من هذا النوع ما رواه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد اللّه بن قسطنطين فلما بلغت: و الضّحى قال لي: كبّر عند خاتمة كلّ سورة حتّى تختم (1)، و أخبره أنّه قرأ على مجاهد فأمره بذلك و أخبره مجاهد أن ابن عبّاس أمره بذلك و أخبره ابن عباس أن أبيّ بن كعب أمره بذلك، و أخبره أبيّ أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم أمره بذلك، و رواه ابن الجزريّ متصل السلسلة إلى عكرمة.
هذان نوعان مهمّان، و لأئمة القرّاء فيهما تصانيف، و الكلام في ذلك في أمرين: ما يوقف عليه و يبتدأ به، و كيفيّة الوقف، و الحاجة إلى الأمر الأوّل أهمّ من الثاني كما لا يخفى، و عجبت للبلقيني كيف تركه و تكلّم في الثاني.
الأوّل: الأفضل الوقف عند رأس كلّ آية للحديث السّابق في النّوع الرّابع و العشرين، و ممّن اختاره: أبو عمرو بن العلاء و البيهقي في الشعب و خلائق. ثم الكلام إمّا أن يكون تاما بأن لا يكون له تعلّق بما بعده البتة لا معنى و لا لفظا فالوقف عليه يسمّى بالتّام، و يبتدأ بما بعده و أكثره في رءوس الآي و انقضاء القصص، و قد يكون قبل انقضاء الآية نحو وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً [ (27) النمل: 34] فيه انقضاء حكاية كلام بلقيس ثم قال تعالى:
وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ كذا قال ابن الجزري و فيه بحث.
و قد يكون وسط الآية نحو: لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي [ (25) الفرقان: 29] و بعد الآية بكلمة نحو: مِنْ دُونِها سِتْراً كَذلِكَ [ (18) الكهف: 90، 91]، و قد يكون تاما
ص: 81
على تفسير و إعراب، غير تامّ على آخر كآية: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [ (3) آل عمران: 7] و إن كان له تعلّق به من جهة المعنى فقط فالوقف عليه يسمّى بالكافي و يبتدأ بما بعده أيضا أو من جهة اللّفظ فقط فهو الحسن يوقف عليه و لا يجوز الابتداء بما بعده إلّا أن يكون رأس آية، و قد يكون كافيا و حسنا على تأويل و غيرهما على آخر نحو: يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ [ (2) البقرة: 102]، كاف إن جعلت «ما» بعده نافية، حسن إن جعلت موصولة و إن لم يتمّ الكلام فهو الوقف القبيح و إنما يجوز ضرورة بانقطاع النّفس، كالوقف على المضاف و المبتدأ و الموصول و النعت دون متمّماتها و بعضه أقبح من بعض، و المراد بالقبح من جهة الأداء لا الشّرع فليس بحرام و لا مكروه إلّا إن قصد تحريف المعنى عن مواضعه و خلاف ما أراده اللّه تعالى فإنه يحرّم و من الوقف ما يتأكّد استحبابه، و هو ما لو وصل طرفاه لأوهم غير المراد و بعضهم عبّر عنه بالواجب و مراده ما تقدم نحو: وَ لا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ [ (10) يونس: 65] و يبتدئ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً لئلّا يوهم أنّ ذلك مقول القول، و قد يجيز قوم الوقف على حرف و آخرون على آخر، و يمتنع الجمع بينهما كالوقف على:
«لا ريب»، و على: «فيه» فإنه لا يجوز على أحدهما إلّا بشرط وصل الآخر، و تغتفر مخالفة ما تقدّم في طول الفواصل و القصص و نحوها و حالة جمع القراءات.
و أمّا الابتداء فلا يكون إلّا اختياريا فلا يجوز إلّا بمستقل، و يكون أيضا: تاما، و كافيا، و حسنا، و قبيحا، بحسب التّمام و عدمه و فساد المعنى و إحالته.
و قد يكون الوقف قبيحا و الابتداء جيّدا نحو: مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا [ (36) يس:
51] فالوقف على الإشارة قبيح لأنه مبتدأ و لإيهامه و الإشارة إلى المرقد، و الابتداء به مع ما بعده كاف أو تامّ، و القرّاء مختلفون في الوقف و الابتداء؛ فنافع كان يراعي محاسنهما بحسب المعنى، و ابن كثير و حمزة: حيث ينقطع النّفس، و استثنى ابن كثير: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [ (3) آل عمران: 7]، وَ ما يُشْعِرُكُمْ [ (6) الأنعام: 109]، إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ [ (16) النحل: 103] فتعمّد الوقف عندها، و أبو عمرو يتعمّد رءوس الآي، و عاصم و الكسائيّ حيث تمّ الكلام و الباقون راعوا أحسن الحالتين وقفا و ابتداء.
الثّاني: قسمان: أحدهما: الوقف على أواخر الكلم، كالمتحرّك و يوقف عليه بالسّكون و هو الأصل، و وردت الرواية عن الكوفيين و أبي عمرو بالإشارة إلى الحركة، و لم يأت عن الباقين شي ء، و استحسنه أكثر أهل الأداء في قراءتهم أيضا. و الإشارة إمّا روم و هي النّطق ببعض الحركة و قيل: تضعيف الصّوت بها حتّى يذهب معظمها، قال ابن
ص: 82
الجزريّ: و القولان بمعنى واحد، و يكون في الضّمّ و الكسر؛ و إمّا إشمام و هو الإشارة إليها بلا تصويت بأن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بها و إنما يكون في الضمّ سواء فيهما حركة البناء و الإعراب إذا كانت لازمة؛ أما العارضة و ميم الجمع عند من ضمّ و هاء التأنيث فلا روم في ذلك و لا إشمام. و قيّد ابن الجزري هاء التأنيث بما وقف عليها بالهاء بخلاف ما يوقف عليها بالتّاء للرسم، و يوقف على: (إذن) و المنوّن المنصوب بالألف.
ثانيهما: الوقف على الرّسم، قال الدّاني: وقف الجمهور عليه، و لم يرو عن ابن كثير و ابن عامر فيه شي ء، و اختار الأئمة الوقوف عليه في مذهبيهما موافقة للجمهور، و قد اختلف عنهم في مواضع منها: الهاء المرسومة تاء فوقف عليها أبو عمرو و الكسائي و ابن كثير في رواية البزّي بالهاء و كذا الكسائي في: مرضات- و اللات- و ذات بهجة- و لات حين- و هيهات- و تابعه البزّي على هيهات هيهات فقط، و كذا وقف ابن كثير و ابن عامر على: (يا أبت) حيث وقع، و وقف الباقون على هذه المواضع بالتاء، و وقف الكسائيّ في رواية الدّوريّ على الياء من: (ويكأنّ اللّه) و روي عن أبي عمرو أنه وقف على الكاف و الباقون على الكلمة بأسرها، و وقفوا على لام نحو: ما لِهذَا الرَّسُولِ [ (25) الفرقان:
7]؛ و عن الكسائي رواية على «ما» و على «اللام»، و عن أبي عمرو على «ما» فقط، و وقف حمزة و الكسائي على: «أيّا» في: أَيًّا ما تَدْعُوا [ (17) الإسراء: 110] و الباقون على «ما» و وقف أبو عمرو و الكسائي بالألف في: (أيّه المؤمنون) [ (24) النور: 31]، (يا أيّه السّاحر) [ (43) الزخرف: 49]، أَيُّهَ الثَّقَلانِ [ (55) الرحمن: 31]، و الباقون بلا ألف، و الكسائي على: وادِ النَّمْلِ [ (27) النمل: 18] خاصة بالياء، و الباقون بدونها، و تفرّد البزّي بزيادة هاء السكت في الوقف على (ما) الاستفهامية مجرورة بحرف، و سكنها غيره، و للباب تتمات تعرف من كتب القراءات.
قال أبو عمرو الدّاني: أمال حمزة و الكسائيّ كلّ اسم أو فعل ألفه منقلبة عن ياء كموسى، و سعى، و مثواكم، و مأواكم، و أنّى بمعنى كيف و متى، و بلى، و عسى، و كذا كلّ مرسوم بالياء إلّا: حتّى، ولدى، و إلى، و على، و ما زكى، و لم يميلا واويّا كالصّفا، و عصا، و شفا جرف، و دعا، و خلا.
و قرأ أبو عمرو ما كان فيه راء بعدها ياء بالإمالة أو رأس آية، آخر آيها على ياء أو هاء، أو كان على وزن فعلى بالفتح أو الكسر أو الضم و لم يكن فيه راءين اللفظين، و ما
ص: 83
عدا ذلك بالفتح، و قرأ ورش جميع ذلك بين اللّفظين إلّا ما كان في سور أواخر آيها على هاء فأخلص الفتح فيه على خلف بين أهل الأداء في ذلك.
و أمال أبو بكر (رمى) في الأنفال، و أعمى في موضعي (سبحان). و أمال أبو عمرو «أعمى» الأوّل فقط، و أمال حفص عن عاصم: (مجرها) [ (11) هود: 41] في هود فقط.
و تفرّد هشام بإمالة: مَشارِبُ [ (36) يس: 73] في يس، و في عَيْنٍ آنِيَةٍ [ (88) الغاشية: 5]، و في «عابد» أي في قوله تعالى: وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ الثلاث في سورة الكافرون، و قرأ الباقون بإخلاص الفتح في كل ما ذكر، هذه أصول الإمالة و مواضع تفرّد حمزة و الكسائيّ، و مشاركة أبي عمرو و الكسائي، و محلّ عدّها كتب القراءات.
تمدّ الهمزة إذا صحبت حرف لين في كل كلمة واحدة تطرّفت أو توسّطت فلا خلاف بينهم في تمكين حرف المد زيادة، فإن كانت الهمزة أوّل كلمة و المدّ آخر كلمة أخرى فاختلفوا في زيادة التمكين له نحو: بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ [ (2) البقرة: 4] فابن كثير و قالون و اليزيدي يقصرون حرف المدّ فلا يزيدونه على ما فيه من المدّ الذي لا يوصل إليه إلّا به، و الباقون يطوّلونه و أطولهم مدّا في الضّربين ورش و حمزة ثم عاصم ثم ابن عامر و الكسائي ثم أبو عمرو من طريق أهل العراق و قالون من طريق أبي نشيط، و هذا كلّه تقريب، و إنما هو على مقدار مذاهبهم في التّحقيق و الحدر، و نقل بعضهم أن مدّ ورش و حمزة قدر ستّ ألفات، و قيل: بل خمس، و قيل: أربع، و عن عاصم: ثلاث، و عن الكسائي قدر ألفين و نصف، و عن قالون: قدر ألفين، و عن السّوسي، ألف و نصف.
هو أربعة أنواع:
أحدهما: النقل لحركتها إلى الساكن قبلها فتسقط نحو: قَدْ أَفْلَحَ [ (23) المؤمنون:
1] بفتح الدال، و به قرأ نافع من رواية ورش، و ذلك حيث كان السّاكن صحيحا آخرا و الهمزة أوّلا، و استثنى أصحاب يعقوب عن ورش: كِتابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ [ (69) الحاقة:
19، 20]، فسكّنوا الهاء و حققوا الهمزة، و أما الباقون فحققوا و سكنوا في جميع ذلك.
ثانيها: إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فتبدل ألفا بعد فتحة، و واوا بعد
ص: 84
ضمة، و ياء بعد كسرة، و به يقرأ أبو عمرو سواء كانت الهمزة فاء أو عينا أو لاما إلّا أن يكون سكونها جزما، أو بناء، أو يكون ترك الهمزة فيه أثقل أو يوقع في الالتباس، فإن تحركت فلا خلاف عنه في التحقيق.
ثالثها: تسهيلها بينها و بين حرف حركتها، فإن اتفقت الهمزتان في الفتح سهّل الثانية: الحرميّان و أبو عمرو و هشام، و أبدلها ورش ألفا و ابن كثير لا يدخل قبلها ألفا، و قالون و هشام و أبو عمرو يدخلونها و الباقون يحققون.
و إن اختلفا بالفتح و الكسر سهّل الحرميّان و أبو عمرو الثانية، و أدخل قالون و أبو عمرو قبلها ألفا و الباقون يحقّقون، أو بالفتح و الضم و ذلك في: قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ [ (3) آل عمران: 15]، أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ [ (38) ص: 8]، أَ أُلْقِيَ [ (54) القمر: 25] فقط، فالثلاثة يسهّلون، و قالون يدخل ألفا، و الباقون يحققون، لكن عن هشام خلاف، قال الدّاني:
و أشار الصحابة إلى التسهيل بكتابة الثانية واوا.
رابعها: إسقاطها بلا نقل و به قرأ أبو عمرو إذا اتفقا في الحركة و كانا في كلمتين، فإن اتفقا كسرا نحو: (هؤلاء إن كنتم) جعل ورش و قنبل الثانية كياء ساكنة، و قالون و البزّي الأولى كياء مكسورة و أسقطها أبو عمرو و الباقون يحقّقون، و إن اتفقا بالفتح نحو: (جاء أجلهم) جعل ورش و قنبل الثانية كمدّة، و أسقط الثلاثة الأولى، و الباقون يحقّقون، أو بالضمّ و هو: (أولياء أولئك) فقد أسقطها أبو عمرو و جعلها قالون و البزّي كواو مضمومة، و الآخران يجعلان الثانية كواو ساكنة و الباقون يحققون، ثم اختلفوا في الساقط هل هو الأولى أو الثانية؟ الأولى عند أبي عمرو و الثانية عند الخليل من النحاة و فائدة الخلاف حكم المدّ، فإن كان السّاقط الأولى فهو منفصل أو الثانية فهو متّصل.
و هو قسمان: إدغام الحرف في مثله، و إدغامه في متقاربه، و الأوّل إمّا في كلمة أو كلمتين، فلم يدغم أبو عمرو المثلين في كلمة إلّا في: مَناسِكَكُمْ [ (2) البقرة: 200] و ما سَلَكَكُمْ [ (74) المدثر: 42] و أظهر ما عداهما نحو: جِباهُهُمْ و وُجُوهُهُمْ و أما في كلمتين فإنه يدغم الأول سواء سكن ما قبله أم تحرك في جميع القرآن إلّا في لقمان فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، و إلّا إذا كان الأول من المثلين مشدّدا أو منونا أو تاء خطاب أو تكلّم، فإن كان معتلا نحو: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ [ (3) آل عمران: 85] ففيه خلاف، إلّا: يا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي [ (11) هود: 30]، وَ يا قَوْمِ ما لِي [ (40) غافر: 41] فلا خلاف فيه و إن كان
ص: 85
معتلا، و أمّا آلَ لُوطٍ حيث وقع فأظهره عامّة البغداديين، و علّله مجاهد بقلة حروف الكلمة، قال الدّاني: و قد أجمعوا على إدغام (لك كيدا) و هو أقل حروفا منه فدلّ على صحة الإدغام فيه، قال: و إن صح الأوّل فذلك لاعتلال عينه إذ كانت هاء فقلبت همزة، و أما المتقاربان فقسمان أيضا، فلم يدغم أبو عمرو أيضا مما في كلمة إلّا القاف المتحرك ما قبلها في الكاف في ضمير جمع المذكر، و أظهر ما عداها و إلقاء الساكن ما قبلها أو التي في غير جمع، و أدغم ممّا في كلمتين: الحاء في العين في: زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ [ (3) آل عمران: 185] فقط، و القاف في الكاف و عكسه إذا تحرّك ما قبلها، و الجيم في الشّين و التاء في: أَخْرَجَ شَطْأَهُ [ (48) الفتح: 29] و ذِي الْمَعارِجِ تَعْرُجُ [ (70) المعارج: 4] فقط، و الشين في السّين في: الْعَرْشِ سَبِيلًا [ (17) الإسراء: 42] فقط، و الضاد في الشين في:
لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ [ (24) النور: 62] فقط، و السّين: في الزّاي و الشين في: النُّفُوسُ زُوِّجَتْ [ (81) التكوير: 7] و الرَّأْسُ شَيْباً [ (19) مريم: 4] فقط، و الدّال: في حروف بمواضع مخصوصة و حيث كسرت أو ضمّت بعد ساكن في الطاء و الذال و التاء و الجيم و السين و في الظاء و الضاد و الشين و الصّاد و الزاي بمواضع مخصوصة، و الثاني: الذال، و الثّاء و الشين و الضاد في مواضع مخصوصة، و في السين مطلقا، و الرّاء: في اللام و عكسه إذا تحرك ما قبلها أو سكن و ضمت أو كسرت، و استثنى: قالَ رَبِّ، وَ قالَ رَبُّكُمُ، و قالَ رَبُّنَا فأدغمه و إن فقد الشرط، و النّون في اللّام و الرّاء إن لم يسكن ما قبلها مطلقا إلّا: وَ نَحْنُ لَهُ و (فما نحن لكما) و فَما نَحْنُ لَكَ. و الباء في الميم في: وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ [ (2) البقرة: 284] حيث وقع لا غير، فهذه أصول الإدغام و تعداد صورها، و محله كتب القراءات.
هذان النّوعان من زيادتي و هما و الإدغام إخوة عند القرّاء، و لم يذكر الإظهار و إن جرت عادتهم بذكره لأنه الأصل كما لم يذكر مع المفهوم المنطوق، و مع المؤوّل الظّاهر، فأما الإخفاء فيكون في الميم فتسكن عند الياء إذا تحرّك ما قبلها فتخفى حينئذ بغنّة نحو: يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، مَرْيَمَ بُهْتاناً [ (4) النساء: 156]، بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ [ (6) الأنعام: 53] قال الفرّاء و قد عبّر بعض المتقدمين عن هذا الإخفاء بالإدغام و ليس بصواب، و أما الإقلاب: فالنون تقلب ميما قبل الباء إذا كانت ساكنة سواء كانا في كلمة أو كلمتين.
ص: 86
هذا النّوع من زيادتي، و الحاجة إليه أهمّ و أشدّ مما قبله في كيفية النّطق بألفاظ القرآن الكريم، فالصّحيح عند القرّاء و متقدّمي النّحاة كالخليل أنّ المخارج سبعة عشر، و قال كثير من الفريقين: ستّة عشر فأسقطوا مخرج الحروف الجوفية التي هي حروف المدّ و اللّين و جعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق و الراء من مخرج المتحرّكة و كذا الياء، و قال قطرب و الجرمي و الفرّاء و ابن دريد: أربعة عشر فأسقطوا مخرج النّون و اللام و الراء و جعلوهما من مخرج واحد.
قال ابن الحاجب: و كلّ ذلك تقريب و إلّا فلكلّ حرف مخرج على حدة.
قال الفرّاء: و اختيار مخرج الحرف محقّقا أن يلفظ بهمزة الوصل و تأتي بالحرف بعدها ساكنا أو مشدّدا و هو أبين ملاحظا فيه صفات ذلك الحرف.
المخرج الأول: الجوف للألف و الواو و الياء السّاكنتين بعد حركة تجانسهما.
الثاني: أقصى الحلق للهمزة و الهاء.
الثّالث: وسطه للعين و الحاء المهملتين.
الرّابع: أدناه أي الفم للغين و الخاء.
الخامس: أقصى اللّسان مما يلي الحلق و ما فوقه من الحنك للقاف.
السّادس: أقصاه من أسفل مخرج القاف قليلا و ما يليه من الحنك للكاف.
السّابع: وسطه بينه و بين وسط الحنك للجيم و الشّين و الياء.
الثّامن: للضّاد المعجمة من أوّل حافّة اللّسان و ما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر و قيل: الأيمن.
التّاسع: للّام: من حافة اللّسان من أدناها إلى منتهى طرفه و ما بينها و بين ما يليها من الحنك الأعلى.
العاشر: للنّون من طرفه أسفل اللام قليلا.
الحادي عشر: للرّاء من مخرج النّون لكنها أدخل في ظهر اللّسان.
الثّاني عشر: للطّاء و الدّال و التّاء من طرفه و أصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك.
الثالث عشر: لحروف الصّفير: الصّاد و السّين و الزّاي من بين طرف اللسان و فويق الثّنايا السّفلى.
ص: 87
الرّابع عشر: للظّاء و الذّال و الثّاء من بين طرفه و أطراف الثنايا العليا.
الخامس عشر: للفاء من باطن الشّفه السّفلى و أطراف الثّنايا العليا.
السّادس عشر: للباء و الميم و الواو غير المدّيّة بين الشفتين.
السّابع عشر: الخيشوم للغنّة في الإدغام و النّون أو الميم الساكنة، و لبعض هذه الحروف فروع صحت بها القراءة كالهمزة المسهّلة و ألف الإمالة و التفخيم و صاد الإشمام و لام التفخيم، و صفات الحروف مبسوطة في كتب القراءات و كتب النحو.
هذا نوع مهمّ و للنّاس فيه تصانيف، و أشهرها للقدماء: غريب أبي عبيدة، معمر بن المثنّى و هو فيما أظنّ أوّل من صنّف فيه، و أشهرها الآن و أكثرها استعمالا و أحسنها تلخيصا و وجازة غريب «العزيزي» فقد أقام في جمعه خمس عشرة سنة يحرّره هو و شيخه أبو بكر ابن الأنباري، و لأبي حيّان في ذلك كتاب لطيف مختصر و ينبغي الاعتناء به. فقد توقّف الصّحابة في ألفاظ منه حتى سألوا عنها و وقفوا عليها.
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد في الفضائل: حدّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السّماوات و الأرض حتّى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها.
و قال أيضا: حدّثنا محمد بن يزيد عن العوّام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا [ (80) عبس: 31] فقال: أيّ سماء تظلّني، و أيّ أرض تقلّني إن أنا قلت في كتاب اللّه ما لا أعلم.
و قال: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه قرأ على المنبر: وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأبّ؟ ثم رجع إلى نفسه و قال: إن هذا لهو التكلّف يا عمر.
و قد عرفه ابن عباس كما رواه إسحاق بن راهويه فقال: حدثنا المغيرة ابن سلمة المخزومي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب حدّثني أبيّ عن ابن عبّاس قال: قال لي عمر ما تقول في ليلة القدر؟ فقلت له: إني سمعت اللّه تعالى أكثر ذكر السّبع فذكر السّماوات سبعا و الأرضين سبعا فقال: كل ما قد قلته عرفته غير هذا ما تعني بقولك: و ما أنبتت الأرض سبعا- فقال: إنّ اللّه يقول: فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا. وَ عِنَباً وَ قَضْباً.
ص: 88
وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًا. وَ حَدائِقَ غُلْباً. وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا [ (80) عبس: 27، 31] فالحدائق: كلّ ملتفّ حديقة، و الأبّ: ما أنبتت الأرض مما لا يأكل الناس. الحديث.
و قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن منصور سألت سعيد بن جبير عن قوله:
وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا [ (19) مريم: 13] فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شيئا، و كذا رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا و اللّه ما أدري ما حنانا.
و هو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، و لا خلاف في وقوع الأعلام الأعجميّة في القرآن، و اختلفوا هل وقع فيه غيرها؟ فالأكثر و منهم الشّافعيّ و ابن جرير أنكروا ذلك لقوله تعالى: قُرْآناً عَرَبِيًّا [ (12) يوسف: 2]، و قوله: لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ [ (41) فصلت: 44] و أجابوا عن ما يوهم ذلك بأنه مما اتفقت فيه لغة العرب و لغة غيرهم كالصّابون، و ذهب جماعة إلى الوقوع.
و أجابوا عن الآية الأولى بأن ذلك لا يخرجه عن كونه عربيّا لأن القصيدة لا يخرجها عن كونها عربيّة كلمة فيها فارسيّة.
و عن الثانية: بأن المعنى: أ كلام أعجميّ و مخاطب عربيّ، و قد ورد عن جماعة من الصّحابة و التّابعين تفسير ألفاظ فيه أطلقوا أنّها بلسان غير العرب، فعن ابن عباس في قوله تعالى: طه هو كقوله: (يا محمّد) بلسان الحبشة رواه الحاكم، و عنه في قوله تعالى:
إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ [ (73) المزمل: 6] قال: بلسان الحبشة: إذا شاء قام، رواه الحاكم و البيهقيّ و هو في البخاري تعليقا، و عن البراء بن عازب في قوله تعالى: سَرِيًّا [ (19) مريم: 24] قال: نهر صغير بالسّريانيّة علّقه البخاري، و عن أبي موسى الأشعري في قوله تعالى: يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ [ (57) الحديد: 28] قال: ضعفين بالحبشيّة، أخرجه وكيع، و قال أبو ميسرة: الأوّاه: الرّحيم بالحبشيّة، و قال سعيد بن عياض الثمالي: (المشكوة) الكوّة الحبشية، و قال مجاهد: القسطاس: العدل بالرّومية، رواها كلّها البخاري تعليقا.
و قد جمع الشيخ تاج الدين السبكي في ذلك سبعا و عشرين لفظة في أبيات و استدرك عليه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر أربعا و عشرين ذيلها على أبياته و وطأ لها قبل ببيت من المعرّب:
من المعرّب عدّ التاج كزّ وقد *** ألحقت كدّ وضمّتها الأساطير
السّلسبيل وطه كوّرت بيع *** روم وطوبى وسجّيل وكافور
والزّنجبيل ومشكاة سرادق مع *** استبرق صلوات سندس طور
ص: 89
كذا قراطيس ربّانيّهم وغسّاق *** ثم دينار القسطاس مشهور
كذاك قسورة واليمّ ناشئة *** ويؤت كفلين مذكور ومسطور
له مقاليد فردوس يعدّ كذا *** فيما حكى ابن دريد منه تنّور
وزدت حرم ومهل والسّجلّ يعدّ كذا *** السّريّ والأبّ ثم الجبت مذكور
وقطّنا وإناه متّكئا *** دارست يصهر منه فهو مصهور
وهيت والسّكر الأوّاه مع حصب *** وأوّبي معه والطّاغوت مسطور
صرهنّ إصري وغيض الماء مع وزر *** ثمّ الرقيم مناص والسّنا النّور
و هو فنّ عظيم متّسع بالغت فيه العرب لاستعمالهم له كثيرا، و نفى الظّاهريّة وقوعه في القرآن، قالوا لأنّه كذب، فإنّ قولك للبليد: هذا حمار كذب و القرآن منزه عنه.
قلت: الّذي قال هذا حمار، فقد اتّفق أهل البلاغة على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، و قد صنّف العلماء في مجاز القرآن كتبا منهم: الشّيخ عزّ الدين بن عبد السلام، و له أنواع كثيرة ذكر منها البلقيني نزرا يسيرا و اقتصر على ما أورده أبو عبيد في أوّل غريبه، و قد سردنا هنا من أنواعه ما لم يجتمع في كتاب:
الأوّل: الحذف و الاختصار كقوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ [ (2) البقرة: 184] أيّ: فأفطر فعدّة، أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ. يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ [ (12) يوسف: 44، 45] أي فأرسلوه فجاء فقال: يا يوسف، و كثر في القرآن حذف المبتدأ و الخبر و المفعول و الجواب نحو: وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ [ (24) النور: 20]، أي: لعذّبكم وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ [ (6) الأنعام: 27] أي لرأيت أمرا عظيما ق. وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ أي لتبعثنّ أو نحو ذلك، و ربّما يطلق على هذا النّوع الإضمار، و بعضهم يجعله قسيما للمجاز لا قسما منه و قال القرافيّ: هو أربعة: قسم يتوقّف عليه صحّة اللّفظ و معناه من حيث الإسناد نحو: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ [ (12) يوسف: 82] أي أهلها، إذ لا يصحّ إسناد السّؤال إليها، و قسم يصحّ بدونه لكن يتوقف عليه شرعا كآية المريض السابقة و قسم يتوقّف عليه عادة لا شرعا نحو: اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ [ (26) الشعراء: 63] أي فضربه، و قسم يدلّ عليه دليل غير شرعي و لا هو عادة نحو:
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ [ (20) طه: 96] دلّ الدليل على أنّه إنما قبض من أثر حافر فرس الرّسول، و ليس في هذه الأقسام مجاز إلّا الأوّل.
ص: 90
الثّاني: الزّيادة نحو: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ [ (42) الشورى: 11]، فكاف زائدة، إذ القصد نفي المثل لا نفي مثل المثل فَلا أُقْسِمُ أي: أقسم، فلا زائدة هَلْ مِنْ خالِقٍ [ (35) فاطر: 3] أي: هل خالق. وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ [ (46) الأحقاف: 29] أي فيما مكّنّاكم، فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَ نادَيْناهُ [ (37) الصافات: 103، 104] الواو في:
(و ناديناه): زائدة لأنه جواب لمّا.
الثّالث: التكرار و هو كثير نحو: كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ [ (78) النبأ: 4، 5].
الرّابع: إطلاق واحد من المفرد و المثنّى و الجمع على آخر منها، فمثال إطلاق المفرد على المثنّى: وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ [ (9) التوبة: 62] أي يرضوهما فأفرد لتلازم الرّضاءين، و على الجمع إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ [ (103) العصر: 2] أي الأناسيّ بدليل الاستثناء منه، و إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً بدليل: إِلَّا الْمُصَلِّينَ [ (70) المعارج:
19، 22] وَ الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ [ (66) التحريم: 4]، و مثال إطلاق المثنّى على المفرد:
أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ [ (50) ق: 24] أي ألق، و على الجمع: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ [ (67) الملك: 4] و مثال إطلاق الجمع على المفرد: قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ [ (23) المؤمنون: 99] أي أرجعني و على المثنّى: قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ [ (41) فصلت: 11]، قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ [ (38) ص: 22]، فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [ (4) النساء: 11]، فإنّها تحجب بالأخوين فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما [ (66) التحريم: 4] أي قلباكما، وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ ... إلى أن قال: وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ [ (21) الأنبياء: 78].
الخامس: تذكير المؤنّث تفخيما له نحو: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ [ (2) البقرة: 275].
السّادس: التّقديم و التّأخير، و مثّل له البلقيني بتقديم المفعول و الخبر و تأخير الفعل و الفاعل، و مثّل له ابن قتيبة بأمثلة دقيقة منها: أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً. قَيِّماً [ (18) الكهف: 1، 2] أراد: أنزل الكتاب قيّما و لم يجعل له عوجا، و قوله: فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ [ (11) هود: 71]، أي بشّرناها فضحكت، و قوله: فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا [ (9) التوبة: 55] أراد: فلا تعجبك أموالهم و لا أولادهم في الحياة الدّنيا إنما يريد اللّه ليعذّبهم بها في الآخرة.
السّابع: إسناد الشّي ء إلى ما ليس له للملابسة نحو: عِيشَةٍ راضِيَةٍ [ (69) الحاقة:
21] أي: مرضية وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً [ (8) الأنفال: 2] أي: زادهم اللّه بها- يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ [ (28) القصص: 4] أي يأمر بذبحهم، يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً [ (40)
ص: 91
غافر: 36] أي: مر بالبناء يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً [ (73) المزمل: 7]- وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها [ (99) الزلزلة: 2] و لم يفهم البلقيني هذا النوع فمثل له بمثال آخر غير مطابق.
الثّامن: القلب، و ممن جوّزه في القرآن أبو عبيدة و ابن قتيبة خلافا لأبي حيّان في قوله إنّه ضرورة فلا يكون فيه، فإن الأصح أنه إن اقتضى معنى لطيفا قبل، و ذكر ابن قتيبة منه: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي [ (26) الشعراء: 77] أي فإنّي عدوّ لهم، بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [ (75) القيامة: 14] أي: بل على الإنسان من نفسه بصيرة: خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ [ (21) الأنبياء: 37] أي: خلق العجل كائنا من الإنسان بدليل: وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا [ (17) الإسراء: 11] و ذكر منه غيره: ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ [ (28) القصص:
76] أي: لتنوأ العصبة بها فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ [ (9) التوبة: 28] أي: فعمّيت عليها.
و منه نوع يسمّى: قلب التّشبيه نحو: أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ [ (16) النحل: 17] إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا [ (2) البقرة: 275]، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ [ (33) الأحزاب: 32] و التّشبيه المقلوب أبلغ من غيره، و لهذا اتّفق عليه من خالف في غيره.
التّاسع: استعمال لفظ موضع غيره و أقسامه منتشرة، فمنها: تسمية الشّي ء باسم جزئه: بِما قَدَّمَتْ يَداكَ [ (22) الحج: 10]، أو عكسه نحو: يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ [ (2) البقرة: 19] أي: أناملها، أو باسم سببه: يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً [غافر:
19] أو ما كان عليه وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ [ (4) النساء: 2]، أو ما يؤول إليه: أَعْصِرُ خَمْراً [ (12) يوسف: 36] أو محلّه: فَلْيَدْعُ نادِيَهُ [ (96) العلق: 7] أو حالّه: فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ [ (3) آل عمران: 107]، أو آلته: وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ [ (26) الشعراء:
84]، و منها: ذكر الماضي موضع المستقبل لتحقّق وقوعه أَتى أَمْرُ اللَّهِ [ (16) النحل: 1] و عكسه وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا [ (13) الرعد: 43] و الخبر موضع الأمر:
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ [ (2) البقرة: 228]، و عكسه: وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً [ (9) التوبة: 82]، و الخبر موضع الدّعاء: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ [ (51) الذاريات: 10] و موضع النّهي: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [ (56) الواقعة: 79]، و الأمر لغير الطّلب كالتّهديد: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ [ (41) فصلت: 40]، و الإنذار: قُلْ تَمَتَّعُوا [ (14) إبراهيم: 30]، و التّسخير كُونُوا قِرَدَةً [ (2) البقرة:
65]، و المنّ به: كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ [ (6) الأنعام: 142] و التكوين: كُنْ فَيَكُونُ [ (36) يس: 82]، و التّسوية: فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا [ (52) الطور: 16] و التّعجّب: انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ [ (23) المؤمنون: 48]، و المشورة: فَانْظُرْ ما ذا تَرى [ (37) الصافات:
102]، و التكذيب: قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا [ (7) الأنعام: 150]،
ص: 92
و النّهي لغير الكف: كالتّسوية في الآية السابقة، و الاستفهام لغير طلب التّصور و التّصديق كالاستبطاء مَتى نَصْرُ اللَّهِ [ (2) البقرة: 214]، و التّعجب: ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ [ (27) النمل: 20]، عَمَّ يَتَساءَلُونَ [ (78) النبأ: 1]، و التّوبيخ: أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ [ (26) الشعراء: 165] و الإنكار: أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ [ (6) الأنعام: 40]، و التّقرير: قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ [ (21) الأنبياء:
12] و الوعيد: أَ لَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ [ (77) المرسلات: 16]، و التكذيب: أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً [ (17) الإسراء: 40] و التّهكّم: أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ [ (11) هود: 87]، و التّحقير: مِنْ فِرْعَوْنَ [ (44) الدخان: 31] على قراءة فتح الميم، و الاستبعاد:
أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى [ (44) الدخان: 13]، و الأمر: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [ (5) المائدة: 91]، و التّمني: فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ [ (7) الأعراف: 53] و التّنبيه على الضّلال: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ [ (81) التكوير: 26] و التّسوية: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ [ (2) البقرة: 6]، و النّفي:
هَلْ مِنْ خالِقٍ [ (35) فاطر: 3] و سوق المعلوم مساق غيره: و يسمّى في غير القرآن تجاهل العارف- و الإعنات نحو: الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ، و التّشويق: هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ [ (38) ص: 21] و التّحقيق: هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ [ (76) الدهر: 1] و منها: استعمال لفظ العاقل لغيره نحو قوله: قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ [ (41) فصلت: 11] و منها: إنابة حروف الجرّ و غيرها عن بعضها في المعنى و ذلك كثير جدا و لا التفات إلى من منع دخول المجاز في الأفعال و الحروف.
العاشر: نسبة الفعل إلى شيئين هو لأحدهما فقط، ذكره ابن قتيبة و مثّل له بقوله تعالى: فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما [ (18) الكهف: 61]، و النّاسي يوشع بدليل قوله: فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ [ (18) الكهف: 63]، و قوله: يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ [ (6) الأنعام: 130] و الرّسل من الإنس دون الجنّ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ إلى قوله:
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ [ (55) الرحمن: 18، 22]، و إنّما يخرج من الملح دون العذب، فهذا ما لخّصته من أنواع المجاز، و لو عددت أقسام كل نوع لقاربت المائة و ذلك من فضل اللّه و لا حول و لا قوّة إلّا به، و من أنواع المجاز ما له اسم خاصّ مفرد بنوع و سيأتي الكلام عليه في محاله.
الاشتراك: أن يتّحد اللّفظ و يتعدّد المعنى، و اختلف في وقوعه، فمنعه ثعلب و الأزهريّ و البلخي، و منع قوم وقوعه في القرآن، و ادّعى قوم أنّه واجب الوقوع لأن المعاني أكثر من الألفاظ، و الأصحّ أنه واقع في القرآن و غيره لا على سبيل الوجوب،
ص: 93
فيمنه: (القرء) مشترك بين الحيض و الطّهر و (عسعس) لإقبال اللّيل و إدباره، و (النّد) للمثل و الضّدّ و (الدّين) للطّاعة و الجزاء، و (المولى) للسّيّد هُوَ مَوْلاكُمْ [ (22) الحج: 78] و القريب: وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي [ (19) مريم: 5]، و وراء: لخلف و أمام، و (البلاء) للنّعمة و النّقمة، و (الثّواب) للتّائب و قابل التّوبة، و (المضارع) للحال و الاستقبال على الأصحّ من خمسة أقوال بيّنّاها في مؤلّفاتنا النّحويّة.
الترادف اتّحاد المعنى و تعدّد اللّفظ، و اختلف أيضا وقوعه، فنفاه ثعلب و ابن فارس، و الأصحّ وقوعه فمنه: الإنسان و البشر، و الحرج و الضّيق، و الرّجس و العذاب، و اليمّ و البحر.
قال البلقيني: و كذلك الإيمان و الإسلام كلّ منهما يشمل الآخر عند الإفراد فإن جمع بينهما تخصّصا بالذكر، و مثلهما في ذلك: الشّرك و الكفر، و الفي ء و الغنيمة، و الفقير و المسكين، و قد قست على ذلك في النّحو: الظّرف و الجار و المجرور.
الأصحّ أنّه يجوز وقوع كلّ من الرّديفين مكان الآخر ما لم يكن متعبّدا بلفظه كلا إله إلّا اللّه، فلا يجزئ: لا إله إلّا الرّحمن، و محمّد رسول اللّه فلا يجزئ: أحمد رسول اللّه.
هذان النّوعان من زيادتي، و قد اعتذر البلقيني عن إهمالهما بما لا يقبل قال تعالى:
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ [ (3) آل عمران: 7] الآية. و اختلف في المحكم و المتشابه ما هو و في تفسيره، و هل المتشابه مما يختصّ اللّه بعلمه؟ فعن ابن عباس: المحكم: ناسخه و حلاله و حرامه و حدوده و فرائضه و ما نؤمن به و نعمل به، و كذا روي عن عكرمة و مجاهد و قتادة و الضّحّاك و مقاتل و غيرهم أنهم قالوا: المحكم: ما يعمل به، و عن ابن عباس: المحكم قوله تعالى: قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ [ (6) الأنعام: الآيات 151، 153].
و قوله: وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [ (17) الإسراء: الآيات 23، 25] الثلاثة. و قال يحيى بن يعمر: الفرائض و الأمر و النّهي و الحلال و الحرام. و قال سعيد بن جبير: هنّ أمّ
ص: 94
الكتاب أي أصله لأنّهنّ مكتوبات في جميع الكتب، و قال مقاتل: لأنه ليس من دين إلّا يرضى بهنّ.
و قيل في المتشابه: إنه المنسوخ و المقدّم و المؤخّر و الأمثال و الأقسام و ما يؤمن به و لا يعمل به. و روي عن ابن عبّاس، و قال مقاتل: هي الحروف المقطّعة في أوائل السّور.
و اختلف النّاس في تفسير المتشابه بحسب اختلافهم في: هل يعلمه الرّاسخون أو لا؟ فعلى الأول هو ما لم يتّضح معناه، و على الثّاني: ما استأثر اللّه بعلمه. و كذا اختلف القرّاء في الوقف: هل هو على قوله: (إلّا اللّه) أو (و الرّاسخون في العلم)؟ و الذي عليه الجمهور أن المتشابه لا يعلمه إلّا اللّه، فقد روى البخاري من حديث عائشة قالت: تلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم هذه الآية هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ ... الآية فقال: فإذا رأيت الّذين يتّبعون ما تشابه منه فأولئك الّذين سمّى اللّه فاحذرهم.
هذا النوع من زيادتي، و يشبهه من أنواع علم الحديث: مختلف الحديث و الفرق بينه و بين المتشابه: أن المتشابه لا يفهم معناه و المراد منه و هذا يفهم بالجمع، إذ المراد منه الآيات التي ظاهرها التّعارض المنزّه عنه كلام اللّه، و قد صنّف ابن قتيبة كتابا جيدا في هذا النوع.
مثال ذلك ما رواه الحاكم و علّقه البخاري: أنّ رجلا سأل ابن عبّاس عن قوله تعالى:
وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ [ (6) الأنعام: 23]، و قوله في آية أخرى: وَ لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً [ (4) النساء: 42]، فقال ابن عباس: أمّا قوله: وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ فإنهم لما رأوا يوم القيامة أنّه لا يدخل الجنّة إلّا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد فختم اللّه على أفواههم فتكلّمت أيديهم و أرجلهم فلا يكتمون اللّه حديثا.
و كذا روي عنه في آيات نحو ذلك: أنّ في القيامة مواقف ففي بعضها ينكرون، و في بعضها يقرّون و في بعضها يسألون و في بعضها لا يسألون كما قال تعالى: وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ [ (52) الطور: 25] و قال تعالى في آية أخرى: فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يَتَساءَلُونَ [ (23) المؤمنون: 101]. و قال: فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ [ (15) الحجر: 92، 93]، و قال في آية أخرى: فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ [ (55) الرحمن: 29] و قال تعالى: وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ [ (43) الزخرف: 52]، و قال:
إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ [ (28) القصص: 56] و الجمع أنّ الهدى مشترك فيطلق على الدلالة و هو المنسوب إليه في الأوّل، و على خلق الاهتداء و هو المنفيّ عنه في الثاني.
ص: 95
و من رسخ قدمه في معرفة موادّ العرب و استعمالاتها و فنون اللّغة و رزق فهما و بصيرة لم يخف عليه الجمع بين الآيات المشكلة. و قد روي أن ابن عباس توقّف في بعض ذلك فروى أبو عبيد: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن: يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ [ (32) السجدة: 5] فقال له ابن عبّاس: فما يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ [ (70) المعارج: 4]؟ فقال الرّجل: إنّما سألتك لتحدّثني فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما اللّه في كتابه اللّه أعلم بهما.
المجمل: ما لم تتّضح دلالته، و منع داود الظّاهريّ وقوعه في القرآن و على الأصح في جواز إبقائه على إجماله ثلاثة أقوال: أصحّها: لا يجوز إبقاء المكلّف بالعمل به، و يجوز إبقاء غيره، و من أمثلة ذلك قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ [ (2) البقرة:
43]، وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [ (3) آل عمران: 97]. و قد بيّنت السّنّة أفعال الصّلاة و الحجّ و مقادير نصب الزّكاة في أنواعها و قوله تعالى: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ [ (3) آل عمران: 7] تردّد لفظ (الرّاسخون) بين العطف و الابتداء، و قد حمله الجمهور على الابتداء للحديث السّابق أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ [ (2) البقرة: 228] يحتمل أن يكون الوليّ، و أن يكون الزّوج، و قد حمله إمامنا الشّافعيّ على الزّوج و مالك على الوليّ لما قام عندهما.
إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ [ (5) المائدة: 1] للجهل حينئذ بمعناه، و قد بيّنه بعد نزوله:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [ (5) المائدة: 3] إلى آخره، و اختلف في قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [ (2) البقرة: 275] هل هو عام خصّصت منه السّنّة البيوع الفاسدة أو مجمل بيّنت السّنة ما أجمل منه، أو عامّ اللّفظ مجمل المعنى على أقوال. و ادّعى الحنفيّة أنّ منه: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [ (5) المائدة: 6] لتردّده بين مسح الكلّ و البعض فبيّنه حديث مسح النّاصية، و ردّ بأنّه لمطلق المسح الصّادق بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم و يفيده.
و هي نوع من المجاز لكنّها مختصّة باسم وحده، و بعضهم يطلق على المجاز كلّه استعارة، كأنّك استعرت اللّفظ من مستحقّه الّذي وضع له و نقلته إلى غيره، و منهم من يخصّها بما لم يذكر المستعار له و عرّفها أهل البيان بأنها مجاز علاقته المشابهة، فإطلاق المشفر مثلا على شفة الإنسان إن كان للتّشبيه بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة، أو
ص: 96
لإطلاق المقيّد على المطلق من غير قصد التّشبيه فمجاز و يسمّى: مرسلا، و هي أقسام كثيرة فمنها: تحقيقيّة و هي: ما تحقّق معناها عقلا أو حسّا نحو: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ [ (1) الفاتحة: 5] أي: الدّين الحق أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ [ (6) الأنعام: 122] أي: ضالا فهديناه و منها: تهكّميّة و تمليحيّة، و هما ما استعملا في ضدّه أو نقيضه نحو:
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ [ (3) آل عمران: 21] استعير لفظ: «البشارة» للعذاب، و هي موضوعة للسّرور تهكّما بهم، و منها: مجرّدة و هي: ما قرن بملائم المستعار له نحو: فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ [ (16) النحل: 112] لم يقل: «فكساها» لأنّ الإدراك بالذّوق يستلزم الإدراك باللّمس و لا عكس.
و منها: مرشّحة و هي: ما قرن بما يلائم المستعار منه نحو: أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ [ (2) البقرة: 16]، استعار الاشتراء للاستبدال و الاختيار ثمّ قرنها بما يلائم الاشتراء من الرّبح و التّجارة.
و منها: استعارة بالكناية: و هي أن يضمر التّشبيه في النّفس فلا يصرّح بشي ء من أركانه سوى المشبّه، و يدلّ عليه بأن يثبت للمشبّه أمر مختصّ بالمشبّه به، فنفس التّشبيه هو الكناية، و إثبات ذلك الأمر للمشبّه استعارة تخييليّة نحو: فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ [ (2) البقرة: 16] شبّه ما يدرك من أثر الضّرّ و الألم بما يدرك من طعم الرّيّ و الشبع فأوقع عليه الإذاقة، فتكون الإذاقة بمنزلة الأظفار للمنيّة في قوله:
و إذا المنيّة أنشبت أظفارها و كذا قوله تعالى: جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ [ (18) الكهف: 77] شبّه ميلانه للسّقوط بانحراف الحيّ فأثبت له الإرادة الّتي هي من خواصّ العقلاء، و قوله تعالى: خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ [ (36) يس: 52] بأن لا تقبل الحق بالشي ء الموثوق المختوم ثم أثبت لها الختم.
و منها: تبعيّة و هي أن يكون المستعار فعلا أو صفة أو حرفا كما تقدّم في آية:
فَبَشِّرْهُمْ .. و آية: إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ [ (11) هود: 87]، و منه قوله تعالى:
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً [ (28) القصص: 8] استعيرت لام «كي» التي هي للعلّة للغاية.
و منها: تمثيليّة و هي: ما استعمل فيما شبّه بمعناه الأصليّ تشبيه مبالغة نحو:
وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً [ (3) آل عمران: 103] شبّه استظهار العبد باللّه و وثوقه به و التجاؤه إليه باستمساك الواقع في مهواة مهلكة بحبل وثيق مدلّى من مكان مرتفع يأمن انقطاعه، و لها أنواع أخر مبيّنة في علم البيان.
ص: 97
و هو أيضا نوع من المجاز، و يفارق الاستعارة باقترانه بالأداة و هي الكاف و مثل و كأنّ و نحوها، و إن تجرّد منها لفظا فإن قدّرتها فهو تشبيه و إلّا فاستعارة كقوله تعالى: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ [ (2) البقرة: 18] و التقدير أعمّ من كونه جزء كلام كهذه الآية، و كون الكلام فيه ما يقتضي كقوله تعالى: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [ (2) البقرة: 187] فالخيط الأسود تشبيه لأن بيان الخيط الأبيض بالفجر قرينة على أن الأسود أيضا مبيّن بسواد آخر اللّيل، و من أمثلته قوله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً [ (62) الجمعة: 5]، وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [ (36) يس: 39]، إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ [ (3) آل عمران: 59] و أبلغه المقلوب كما تقدّم في نوع المجاز.
هذان النّوعان من زيادتي و هما مهمّان، و قد ألّف الشّيخ تقي الدّين السّبكي فيهما كتابا، و اختلف النّاس في الفرق بينهما و بين الحقيقة و المجاز بما هو مبسوط في كتب البيان، و الّذي تحرّر منه أن الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا به لازم المعنى، فهي بحسب استعمال اللّفظ في المعنى حقيقة و التّجوّز في إرادة إفادة ما لم يوضع له، و قد لا يراد منها المعنى بل يعبر بالملزوم عن اللازم و هي حينئذ مجاز كقولك: زيد طويل النّجاد، أي طويل حمائل السّيف مريدا به طول القامة الّذي هو لازم لطوله حقيقة.
و منه في القرآن: قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا [ (9) التوبة: 81] فإنّه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم بل إفادة لازمة، و هو أنهم يردونها و يجدون حرّها إن لم يجاهدوا.
و أما التّعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتّلويح بغيره نحو: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا [ (21) الأنبياء: 63] نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتّخذة آلهة كأنّه غضب أن تعبد الصّغار معه تلويحا لعابديها بأنّها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل و الإله لا يكون عاجزا، فهو حقيقة أبدا و منه قوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [ (39) الزمر: 65] الخطاب له صلّى اللّه عليه و سلّم و هو تعريض بالكفّار وَ ما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [ (36) يس: 22] أي: و مالكم لا تعبدون، و قريب مما تقدّم في حدّهما قول الزّمخشري: الكناية ذكر الشي ء بغير لفظه الموضوع له، و التّعريض: أن يذكر شيئا يدلّ على شي ء لم يذكره.
و قول ابن الأثير: الكناية: ما دلّ على معنى يجوز حمله على الحقيقة و المجاز
ص: 98
بوصف جامع بينهما، و التّعريض: اللّفظ الدّالّ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازيّ، يقول من يتوقّع صلة: و اللّه إنّي لمحتاج- فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة و لا مجازا و إنّما فهم من عرض اللّفظ أي جانبه.
هذا النّوع مثاله عزيز إذ ما من عامّ إلّا و يتخيّل فيه التّخصيص، قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ [ (22) الحج: 1] قد يخصّ منه غير المكلّف، و حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [ (5) المائدة: 3] خصّ منه حالة الاضطرار و ميتة السّمك و الجراد، وَ حَرَّمَ الرِّبا [ (2) البقرة:
275] خصّ منه العرايا. و مما يصلح مثالا له: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ [ (4) النساء: 1]، و قوله تعالى: وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ [ (64) التغابن: 11].
النوع الرابع و الخمسون و الخامس و الخمسون: العامّ المخصوص و العامّ الذي أريد به الخصوص
هذان النّوعان من النّاس من لم يفرّق بينهما حيث ذكر العقل من المخصصات و الأصحّ التّفرقة، و للسّبكي فيهما رسالة مستقلّة، و لهم بينهما فروق:
أحدها: أن العامّ الّذي أريد به الخصوص قرينته عقليّة اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ [ (39) الزمر: 62].
الثّاني: أنّ قرينته معه نحو: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ [ (3) آل عمران: 173] قال الشّافعيّ رضي اللّه عنه: فإذا كان من مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ناسا غير من جمع لهم النّاس و كان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم و غير من معه ممّن جمع عليه، و كان الجامعون لهم ناسا فالدّلالة بيّنة بما وصفت من أنّه إنّما جمع لهم بعض النّاس دون بعض و العلم محيط أنه لم يجمع النّاس كلّهم و لم يخبرهم النّاس كلهم و لم يكونوا هم النّاس، و لكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر و على جميع النّاس و على من بين جميعهم و ثلاثة منهم كان صحيحا في لسان العرب أن يقال: (الّذين قال لهم النّاس) و إنما قال ذلك أربعة نفر: (إنّ النّاس قد جمعوا لكم) يعني المنصرفين من أحد.
قال البلقيني: و لم يبيّن الشّافعيّ رضي اللّه عنه سند ما ذكره من أنّهم أربعة نفر، و يحتمل أن يكون صحّ عنده بطريق، انتهى.
و قد ذكر أهل التّفسير أن المراد بالنّاس القائل هو نعيم بن مسعود الأشجعي وحده، و سيأتي الكلام عليه في المبهمات.
ص: 99
الثّالث: أن المراد به الخصوص لا يصحّ أن يراد به العموم بخلاف المخصوص.
الرّابع: أنّه يصحّ أن يراد به واحد اتّفاقا، و المخصوص لا بدّ فيه من جمع أي على خلف فيه.
الخامس: أن المراد منه أقلّ مما خرج و الدّاخل في المخصوص أكثر مما خرج و هو قريب من الّذي قبله.
قلت: بقي فرق آخر هو أعظم ممّا ذكره و هو أن المراد به الخصوص مجاز قطعا لأنّه لفظ استعمل في بعض أفراده، و المخصوص حقيقة على الأصحّ لأن تناول اللّفظ للبعض الباقي في التّخصيص كتناوله له بلا تخصيص و ذلك التّناول حقيقيّ اتّفاقا فكذا هذا.
و من أمثلة: المراد به الخصوص: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ [ (4) النساء: 54] أي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ [ (27) النمل: 23]، وَ آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ سَبَباً [ (18) الكهف: 84]، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْ ءٍ بِأَمْرِ رَبِّها [ (46) الأحقاف: 25].
و أما المخصوص فأمثلته كثيرة جدا.
و قد أنكرهما قوم و قالوا: لا يخصّ الكتاب إلّا بكتاب، و لا السّنّة إلّا بسنّة، و أوجبهما آخرون و قالوا: لا يخصّ الكتاب الكتاب و لا السّنّة السّنّة، و الأصح جواز الجميع.
فأمّا النّوع الأوّل فقليل جدا، و من أمثلته قوله تعالى: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ [ (9) التوبة: 29] خصّ عموم قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: «أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّه»، و قوله تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى [ (2) البقرة: 238] خصّ عموم نهيه صلّى اللّه عليه و سلّم عن الصّلاة في الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض، و قوله تعالى: وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها [ (16) النحل: 80] الآية، خصّ عموم قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: «ما أبين من حيّ فهو ميّت»، و قوله تعالى: وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [ (9) التوبة: 60] خصّ عموم قوله صلّى اللّه عليه و سلّم:
«لا تحلّ الصّدقة لغنيّ و لا لذي مرّة سويّ» فإنهما يعطيان مع الغنى، و كذا سبيل اللّه، و قوله تعالى: فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي (حَتَّى تَفِي ءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ) [ (49) الحجرات: 9] خصّ عموم قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل و المقتول في النّار».
ص: 100
و أما النّوع الثّاني: فأمثلته كثيرة كتخصيص: (و حرّم الرّبا) بغير العرايا، و تخصيص:
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [ (2) البقرة: 228] بالأحرار، و كذا عدّة الوفاة و آيات المواريث بغير القاتل و المخالف في الدّين و الرّقيق، و تخصيص: وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها [ (4) النساء: 86] بغير الكافر و الفاسق و الأحوال التي لا يجب فيها الرّدّ.
هو ما ترك ظاهره لدليل نحو: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [ (5) المائدة: 6] أي: أردتم القيام إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ [ (65) الطلاق: 1]، فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ [ (16) النحل: 98] أي: أردتم الطّلاق و القراءة، و كذا قوله تعالى: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها [ (4) النساء: 93]، دلّ الدّليل على أنّ المؤمن لا يخلّد فأوّل الخلود بالمكث الطّويل أو الأبديّ للمستحل، و التّأويل إنما يقبل إذا قام عليه دليل و كان قريبا، أما البعيد فلا كتأويل الحنفيّة قوله تعالى: فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [ (58) المجادلة: 4] ستّين مدّا على أن يقدّر مضاف، أي إطعام ستّين مسكينا هو ستّون مدّا حتّى جوّزوا إعطاءه لمسكين واحد في ستّين يوما، و وجه بعده: اعتبار ما لم يذكر و هو المضاف و إلغاء ما ذكر و هو العدد، مع ظهور قصده لفضل الجماعة و بركتهم و تظافر قلوبهم على الدّعاء للمحسنين.
و هذا ما دلّ عليه اللّفظ لا في محلّ النّطق، و خلافه المنطوق و هو: ما دلّ عليه في محلّ النّطق و لم يذكره البلقيني لأنّه الأصل و في النّفس منه شي ء فإنّ له أقساما ينبغي التّنبيه عليها و لنتكلّم عليه مضموما إلى هذا النّوع. فأمّا المفهوم فهو قسمان: موافقة- و هو: ما يوافق حكمه المنطوق و يسمّى: فحوى الخطاب إن كان أولى، و لحن الخطاب إن كان مساويا. مثال الأوّل: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ [ (17) الإسراء: 23] فإنه يفهم تحريم الضّرب من باب أولى. و مثال الثّاني: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً [ (4) النساء: 10] الآية فإنه يفهم تحريم الإحراق أيضا لمساواته للأكل في الإتلاف.
و مخالفة: و هو المخالف له إذا لم يخرج الغالب، فإن خرج لم يسمّ مفهوما نحو:
وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [ (4) النساء: 23] إذ الغالب كون الرّبيبة في حجر الزّوج فلا يفهم إباحة الّتي ليست في حجره، و يلحق به نحوه مما لا يقتضي التّخصيص بالذكر لموافقة الواقع نحو: وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ [ (23) المؤمنون: 117]،
ص: 101
وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً [ (24) النور: 33] ثمّ المفهوم إمّا من صفة نحو: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [ (49) الحجرات: 6] فوجب التّبيين في الفاسق، أو عدد نحو: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً [ (24) النور: 4] أي: لا أقل و لا أكثر، أو شرط نحو:
وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ [ (65) الطلاق: 6] أي: فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهنّ. أو غاية نحو: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [ (2) البقرة: 230] أي فإذا نكحته تحلّ للأوّل بشرطه، أو أداة حصر نحو: إِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ [ (20) طه: 98] أي فغيره ليس بإله؛ أو فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو: فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ [ (42) الشورى:] أي: فغيره ليس بوليّ، أو تقديم المعمول نحو: إِيَّاكَ نَعْبُدُ [ (1) الفاتحة: 4] أي: لا غيرك لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ [ (3) آل عمران: 158] أي: لا إلى غيره.
و المنطوق تارة يتوقّف صحة دلالته على إضمار فيسمّى دلالة اقتضاء نحو: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ [ (12) يوسف: 82] أي: أهلها، و تارة لا يتوقّف و يدلّ على ما لم يقصد به فيسمّى دلالة إشارة نحو: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ [ (2) البقرة: 187] فإن المقصود به جواز الجماع في اللّيل و هو صادق بآخر جزء منه فيدل بالإشارة على صحة صوم من أصبح جنبا.
قلت: و قد استنبطت بهذه القاعدة أحكاما من عدّة آيات منها قوله تعالى: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ... إلى قوله: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ (5) المائدة: 33، 34]، أشار بجواب الشّرط بأنّه غفور رحيم إلى أنّ التّوبة إنما تسقط الحقّ المتعلق به تعالى دون المتعلّق بالآدميّ، لأن التّوبة لا تسقطه و توهّم بعض الشّافعيّة من قوله تعالى المولي: فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ (2) البقرة: 226] أنه لا يجب تعالى كفّارة اليمين، لأن اللّه ذكر له المغفرة و الرّحمة، و غفل قائل هذا عن هذه النكتة فالمغفرة فيه لما تعلّق باللّه من الحلف به الذي في الحنث فيه حزازة دون ما تعلّق بالآدميّ من الكفّارة فإن فيها حقا لآدميّ فتأمّل هذا المحلّ فإنّه نفيس جدا.
المطلق: الدّالّ على الماهيّة بلا قيد، و قد اشتهر من مذهب الشّافعي أنه يحمل المطلق على المقيّد و في ذلك تفصيل، لأنهما إن اتّحد حكمهما و موجبهما و كانا مثبتين و تأخّر المقيّد عن وقت العمل بالمطلق فالمقيّد ناسخ للمطلق و إلّا حمل عليه، و كذا إن
ص: 102
كانا منفيّين، و إن كان أحدهما أمرا و الآخر نهيا قيّد المطلق بضدّ الصّفة، و إن اختلف السّبب فمذهب الشّافعيّ الحمل عليه قياسا كما في قوله تعالى في كفّارة القتل: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [ (4) النساء: 92]، و في كفّارة الظّهار: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [ (58) المجادلة: 3]، و إن اتّحد الموجب و اختلف الحكم حمل عليه أيضا كما في قوله تعالى في آية الوضوء:
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ [ (5) المائدة: 6] و في آية التّيمّم: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ [ (5) المائدة: 6].
و أما المقيّد في موضعين بمتنافيين وفد أطلق في موضع و ليس أولى بأحدهما من الآخر. فلا يحمل على شي ء منهما كقوله تعالى في قضاء أيام رمضان: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [ (2) البقرة: 185]، و في كفّارة الظّهار: فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ [ (58) المجادلة: 4] و في صوم التّمتّع: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ [ (2) البقرة: 196] فأوجب التتابع في الثّاني، و التّفريق في الثالث و ليس الأول أولى بأحدهما من الآخر فلا يجب فيه تتابع و لا تفريق.
و قد يكون الكتاب مقيّدا للسّنّة المطلقة، و السّنّة مقيّدة للكتاب المطلق كالتخصيص.
هذان النّوعان مهمان و للنّاس فيهما مصنّفات جمّة، و ذلك على ثلاثة أقسام: الأوّل:
ما نسخ حكمه دون رسمه و هو أضرب: أحدها: ما نسخه كتاب كقوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ ... فإنه منسوخ بقوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [ (2) البقرة: 234]، و كقوله تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ [ (8) الأنفال:
65] الآية، نسخ بقوله: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ [ (8) الأنفال: 66] الآية.
و كقوله تعالى: وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ... إلى قوله: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ [ (4) النساء: 15] نسخ بقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ [ (24) النور: 2].
و هنا فوائد: الأولى: كلّ ما في القرآن من الصّفح عن الكفّار و التّولّي و الإعراض و الكفّ عنهم فهو منسوخ بآية السّيف، قال بعضهم و هي: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
ص: 103
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [ (9) التوبة: 5]. نسخت مائة و أربعا و عشرين آية ثم نسخ آخرها أوّلها.
الثانية: ليس في القرآن ناسخ إلّا و المنسوخ قبله في التّرتيب إلّا آية العدّة السّابقة.
و قوله تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ [ (33) الأحزاب: 52] نسخها قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ [ (33) الأحزاب: 50]. و هي قبلها في التّرتيب، قيل: و قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ [ (7) الأعراف: 199] يعني الفضل من أموالهم، فإنه منسوخ بآية الزّكاة، قالوا: و هي من عجيب المنسوخ فإن أوّلها و آخرها و هو: وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ منسوخ و وسطها و هو: وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ محكم.
الثّالثة: روى أبو عبيد عن الحسن و أبي ميسرة أنهما قالا: ليس في المائدة منسوخ و هو مشكل، ففي المستدرك عن ابن عباس أن قوله تعالى: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [ (5) المائدة: 42] منسوخ بقوله: وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ [المائدة: 49] و قال بعض من صنّف في هذا النّوع: السّور الّتي لا ناسخ فيها و لا منسوخ: الفاتحة، و يوسف، و إبراهيم، و الكهف، و الشّعراء، و يس، و الحجرات، و الرّحمن، و الحديد، و الصّفّ، و الجمعة، و التّحريم، و الملك، و الحاقّة، و نوح، و الجنّ، و القيامة و المرسلات، و النّبأ، و النّازعات، و الانفطار، و المطفّفين، و الانشقاق، و البروج، و الفجر، و خمس بعدها، و القلم و ما بعدها.
و السّور الّتي فيها الناسخ فقط: الفتح، و الحشر، و المنافقون، و التّغابن، و الطّلاق، و الأعلى.
و التي فيها الناسخ و المنسوخ: البقرة، و ثلاث بعدها، و الأنفال، و براءة، و مريم، و الأنبياء، و الحج، و النّور، و الفرقان، و الأحزاب، و سبأ، و المؤمن، و الشّورى، و الذّاريات، و الطّور، و الواقعة، و المجادلة، و المزّمّل، و المدّثر، و التكوير، و البواقي فيها المنسوخ فقط.
الرّابعة: قال السعيديّ لم يمكث منسوخ مدّة أكثر من قوله تعالى: قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ [ (46) الأحقاف: 9] الآية، ثبتت ستّ عشرة سنة حتى نسخها أوّل الفتح عام الحديبية.
الضّرب الثّاني: ما نسخه سنّة، و اختلف في جواز هذا و الّذي بعده، مثاله قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ [ (2) البقرة: 180] نسخة قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: «لا وصيّة لوارث» و من أنكره قال: النّاسخ آية الميراث.
ص: 104
الضّرب الثّالث: ما كان ناسخا لسنّة كآية القبلة فإنّها ناسخة لاستقبال بيت المقدس الثّابت بالسّنّة.
القسم الثّاني: ما نسخ رسمه دون حكمه و هو كثير أيضا فقد قال أبو عبيد: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيّوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقولنّ أحدكم قد أخذت القرآن كلّه قد ذهب منه قرآن كثير و لكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. و قال: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزّبير عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلّى اللّه عليه و سلّم مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلّا على ما هو الآن، و هو ثلاث و سبعون آية قاله الجلالان، و قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النّجود عن زرّ بن حبيش قال: قال لي أبيّ ابن كعب: كم كانت تعدّ سورة الأحزاب؟ قلنا: ثنتين و سبعين آية أو ثلاثا و سبعين آية فقال: إن كانت لتعدل سورة البقرة و إن كنّا لنقرأ فيها آية الرّجم قلت: و ما آية الرّجم؟ قال: إذا زنى الشّيخ و الشّيخة فارجموهما البتّة نكالا من اللّه و اللّه عزيز حكيم، أخرجه الحاكم مختصرا و صحّحه.
و قال أيضا: حدثنا عبد اللّه بن صالح عن اللّيث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم آية الرّجم: (الشّيخ و الشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللّذة).
و قال: حدّثنا حجّاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي حميد عن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ عليّ أبيّ و هو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة: (إنّ اللّه و ملائكته يصلّون على النّبيّ يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه و سلّموا تسليما، و على الّذين يصلّون في الصّفوف الأول)، قالت: قبل أن يغيّر عثمان المصاحف.
و قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالح عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم إذا أوحي إليه أتيناه يعلمنا ممّا أوحي إليه قال: فجئت ذات يوم فقال: إنّ اللّه تعالى يقول: إنّا أنزلنا المال لإقام الصّلاة و إيتاء الزّكاة و لو أنّ لابن آدم واديا لأحبّ أن يكون إليه الثّاني و لو كان له الثّاني لأحبّ أن يكون إليهما الثّالث و لا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب و يتوب اللّه على من تاب.
و قال الحاكم في المستدرك: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسدي
ص: 105
حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم بن إياس حدثنا شعبة عن عاصم عن زرّ عن أبيّ بن كعب قال: قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: إنّ اللّه أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ ... و من بقيّتها: (لو أنّ ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه سأل ثانيا [و إن سأل ثانيا فأعطيه سأل ثالثا و إن سأل ثالثا فأعطيته سأل رابعا] (1) و لا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب و يتوب اللّه على من تاب، و إنّ ذات الدّين عند اللّه الحنيفية غير اليهودية و لا النّصرانية، و من يعمل خيرا فلن يكفره).
و قال أبو عبيد: حدّثنا حجّاج عن حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي موسى الأشعريّ قال: نزلت سورة نحو «براءة» ثمّ رفعت و حفظ منها:
(إنّ اللّه سيؤيّد هذا الدّين بأقوام لا خلاق لهم، و لو أنّ لابن آدم واديين من مال لتمنّى واديا ثالثا و لا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب و يتوب اللّه على من تاب).
و قال الحاكم في المستدرك: حدّثنا عليّ بن حمشاذ العدل حدثنا محمد بن المغيرة اليشكري حدثنا القاسم بن الحكم العرنيّ حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن عبد اللّه ابن مرّة عن عبد اللّه بن سلمة عن حذيفة قال ما تقرءون ربعها يعني «براءة» و إنكم تسمّونها سورة التّوبة و هي سورة العذاب.
و قال أبو عبيد: حدثنا حجّاج عن سعيد عن الحكم بن عيينة عن عديّ بن عديّ قال: قال عمر: كنّا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم، ثمّ قال لزيد بن ثابت:
أ كذلك؟ قال: نعم.
و قال: حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي حدّثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أ لم تجد فيما أنزل علينا: (أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة). فإنّا لا نجدها؟ فقال: أسقطت فيما أسقط من القرآن، و قال: حدّثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي سفيان الكلاعي أنّ مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين من القرآن لم يكتبا في المصحف فلم يخبروه و عندهم أبو الكنود سعد بن مالك، فقال مسلمة: (إنّ الّذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل اللّه بأموالهم و أنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون.
و الّذين آووهم و نصروهم و جادلوا عنهم القوم الّذين غضب اللّه عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون).
ص: 106
و قال الطّبراني حدثنا أبو شبيل عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن واقد حدثنا أبي حدثنا العبّاس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهريّ عن سالم عن أبيه قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فكانا يقرءان بها فقاما ذات ليلة يصلّيان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فذكرا ذلك له فقال: إنّها ممّا نسخ و أنسي فالهوا عنها.
و في الصّحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الّذين قتلوا و قنت صلّى اللّه عليه و سلّم يدعو على قاتليهم قال أنس: و نزل فيهم قرآن قرأناه حتّى رفع: أن بلغوا عنّا قومنا إنّا لقينا ربّنا فرضي عنّا و أرضانا.
القسم الثّالث: ما نسخ رسمه و حكمه معا كما روى البخاريّ عن عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات.
هو قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ [ (58) المجادلة: 12]، قال ابن عطيّة: قال جماعة: لم يعمل بهذه الآية بل نسخ حكمها قبل العمل، و صحّ عن عليّ أنه قال: ما عمل بهذه الآية أحد غيري و لا يعمل بها أحد بعدي. رواه الحاكم و صحّحه و فيه:
كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلّما ناجيت النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت: أَ أَشْفَقْتُمْ [ (58) المجادلة: 13] الآية.
و روى التّرمذيّ عنه قال: لمّا نزلت هذه الآية قال لي النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم: «ما ترى دينارا»؟، قلت: لا يطيقونه، قال: «فنصف دينار»، قلت: لا يطيقونه: قال: «فكم»؟ قلت: شعيرة:
قال: إنك لزهيد فنزلت: أَ أَشْفَقْتُمْ ... الآية، فبي خفّف عن هذه الأمة.
قال مقاتل: بقي هذا الحكم عشرة أيّام، و قال قتادة: ساعة من نهار. قلت: الظاهر قول قتادة كما لا يخفى.
هذا النّوع من زيادتي و هو لطيف إلّا أنّ أمثلته إنّما توجد كثيرة في الحديث و ليس في القرآن منه إلّا خصائص النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم. فمنها: التّهجّد فإنّه كان واجبا عليه وحده صلّى اللّه عليه و سلّم بقوله تعالى: وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [ (17) الإسراء: 79].
و منها: وجوب التّضحية بقوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [ (108) الكوثر: 2].
ص: 107
و منها: وجوب طلاق كارهته بقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إلى قوله:
فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا [ (33) الأحزاب: 28].
و هي من أنواع البلاغة حتّى نقل صاحب «سرّ الفصاحة» أنّ هذه الأنواع هي البلاغة، و اختلف في حدودها و الأقرب ما قاله صاحب التّلخيص: إنّ المقبول من طرق التّعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له، أو ناقص عنه واف، أو زائد عليه لفائدة.
و الأوّل: المساواة، و الثّاني: الإيجاز، و الثّالث: الإطناب. فخرج بقولنا: واف الإخلال.
و لفائدة التّطويل و الحشو، و ذهب ابن الأثير إلى أنّ الإيجاز: التّعبير عن المراد بلفظ غير زائد عنه، و الإطناب: بلفظ زائد عنه فتدخل المساواة في الإيجاز و لا واسطة و الأقرب الأوّل.
و مثّل في التلخيص للمساواة بقوله تعالى: وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ [ (35) فاطر: 43]، و أورد عليه أمران:
أحدهما: أن فيه إطنابا لأنّ السّيّئ زيادة، لأن كلّ مكر لا يكون إلّا سيئا، و لأنه باعتبار ما قبله تذييل لقوله: وَ مَكْرَ السَّيِّئِ [ (35) فاطر: 43].
الثّاني: أنّ فيه إيجازا لأنّ الاستثناء إذا كان مفرّغا ففيه إيجاز القصر، و إلّا ففيه إيجاز قصر بالاستثناء، و إيجاز حذف للمستثنى منه فإن تقديره: «بأحد».
و مثّل في الإيضاح بقوله تعالى: وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ [ (6) الأنعام: 68].
و أمّا الإيجاز فقسمان: إيجاز حذف و سبق أمثلته في مجاز الحذف، و إيجاز قصر:
و هو ما لا حذف فيه، و من أبلغه قوله تعالى: وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ [ (2) البقرة: 179] فإن معناه كثير و لفظه يسير، لأنّه قائم مقام قولنا: الإنسان إذا علم أنّه إذا قتل يقتصّ منه كان ذلك داعيا قويا مانعا له من القتل فارتفع بالقتل الّذي هو قصاص كثير من قتل النّاس بعضهم لبعض فكان ارتفاع القتل حياة لهم، و قد كان عند العرب أبلغ عبارة في هذا المعنى: «القتل أنفى للقتل» فزاد عليه: بقلّة حروف ما يناظره منه.
و النّص على المطلوب، و ما يفيده تنكير «حياة» من التّعظيم لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد، و اطّراده، و خلوّه من التكرار، و استغناؤه عن تقدير محذوف، و المطابقة. و أمّا الإطناب فإنه يكون بأمور:
أحدها: الإيضاح بعد الإبهام نحو: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي [ (20) طه: 25] فإن:
ص: 108
«اشرح لي» يفيد طلب شرح شي ء ما له و «صدري» يفسّره و المقام يقتضي التّأكيد للإرسال المؤذن بتلقّي الشّدائد. و كذا: أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ [ (94) الشرح: 1] فإن المقام يقتضي التأكيد لأنه مقام امتنان و تفخيم.
الثّاني: ذكر الخاصّ بعد العامّ تنبيها على فضل الخاصّ حتّى كأنّه ليس من جنس العام نحو: مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ [ (2) البقرة: 98]، حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى [ (2) البقرة: 238]، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ [ (3) آل عمران: 104].
الثّالث: التّكرير، و تقدّم في المجاز.
الرّابع: الإيغال و هو: ختم الكلام بما يفيد نكتة يتمّ المعنى بدونها نحو: اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ [ (36) يس: 20، 21] لأن المقصود حثّ السّامعين على الاتّباع، ففي وصفهم بالثّاني زيادة مبالغة و حثّ على اتّباع النّاس له من ذكر كونهم مرسلين، و كذا: أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى [ (2) البقرة: 16] الآية فقوله:
وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ إيغال.
الخامس: التّذييل و هو: أن يأتي عقب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد، ثمّ منه ما خرج مخرج المثل لاستقلاله بنفسه نحو: وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً [ (17) الإسراء: 81].
و ما لم يخرج مخرجه لعدم استقلاله نحو: ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ [ (34) سبأ: 17]، و اجتمعا في قوله: وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ [ (21) الأنبياء: 34، 35]، فإن: أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ من الثاني و كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ من الأوّل.
و منه نوع سمّاه بعضهم: حشو التّمهيد كقوله تعالى: إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً [ (27) النمل: 34] الآية، فقوله تعالى: وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ تقرير لكلام «بلقيس» لا من تتمة كلامها.
السّادس: التكميل و يسمّى أيضا: احتراسا و هو: أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه نحو: أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ [ (5) المائدة: 54] فلو اقتصر على: (أذلّة) لتوهّم أنّهم أذلّة لضعفهم فجاء قوله: (أَعِزَّةٍ) لنفي ذلك. و كذلك:
ص: 109
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ [ (48) الفتح: 29] لأنه لو اقتصر على الأوّل لأوهم الغلظة و الفظاظة، و كذا: وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ بين: قالوا نشهد إنّك لرسول اللّه: وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ [ (63) المنافقون: 1] و لولاه لكان يوم ردّ التكذيب إلى نفس الشّهادة.
السّابع: التتميم، و هو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة كالمبالغة نحو: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ [ (76) الإنسان: 8]، وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ [ (2) البقرة: 177] أي مع حبه فإن الإطعام و إيتاء المال مع حبّه أبلغ.
الثّامن: الاعتراض- و هو: أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متّصلين معنى بجملة أو أكثر لا محلّ لها من الإعراب لنكتة كالتّنزيه في قوله تعالى: وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ [ (16) النحل: 57]. «فسبحانه» هنا تضمّنت تنزيها للّه تعالى عن البنات، و كقوله تعالى: وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ [ (31) لقمان: 14] قوله: «حَمَلَتْهُ» إلى آخره اعتراض لتأكيد الوصية، و قوله: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [ (2) البقرة: 223، 224] فنساؤكم متصل بقوله: فَأْتُوهُنَّ لأنّه بيان له و ما بينهما اعتراض و أمثلته في القرآن كثيرة.
و قد يكون الإطناب بغير أحد هذه الأمور نحو: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ [ (40) غافر: 7] فقوله: وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ إطناب لأن إيمانهم ليس ممّا ينكر، و حسّن ذكره إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه، و كذا قوله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ [ (2) البقرة: 164] الآية، فيها أبلغ الإطناب لكونها وردت مع المنكرين وحدانيّة اللّه تعالى الطّالبين على ذلك دليلا.
هذا النّوع من زيادتي و المراد به الآيات المتشابهة، و حكمة تكرارها و نكتته: ما في إحدى المتشابهتين ممّا ليس في الأخرى من تقديم أو تأخير أو زيادة، و قد صنّف في ذلك جماعة تصانيف منها: البرهان في متشابه القرآن لمحمود بن حمزة الكرماني، و من أمثلته:
الرّحمن الرّحيم في الفاتحة، كرّره بعد ذكره في البسملة تأكيدا لرحمته تعالى، و لأنّه ذكره أولا مع المنعم عليهم فأعاده معهم و هم العالمون، و أشار بالرّحمن إلى أنّه رحمن لجميعهم في الدّنيا، و بالرّحم إلى أنّه خاص بالمؤمنين يوم الدّين، و منها قوله تعالى في
ص: 110
البقرة: اهْبِطُوا مِنْها مكرّرا في موضعين، لأن المراد بالأوّل: الهبوط من الجنّة. و الثّاني من السّماء.
و منها قوله فيها: يُذَبِّحُونَ بغير واو، و كذا في الأعراف يَقْتُلُونَ و في إبراهيم بالواو، لأن الأوّلين من كلام اللّه فلم يرد تعداد المحن عليهم؛ و الثّالث من كلام موسى لهم فعدّدها عليهم و كان مأمورا بذلك في قوله: وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ.
و منها قوله فيها: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصَّابِئِينَ [ (2) البقرة: 62] و قال في الحجّ: وَ الصَّابِئِينَ وَ النَّصارى [ (22) الحج: 17]، و في المائدة: وَ الصَّابِئُونَ وَ النَّصارى [ (5) المائدة: 69] لأن النّصارى تقدّم على الصّابئين في الرتبة لأنهم أهل كتاب فقدّمهم في البقرة، و الصّابئين تقدّم في الزّمان لأنّهم كانوا قبلهم فقدّمهم في الحجّ، و راعى في المائدة المعنيين فقدّمهم في اللّفظ و أخرهم في التّقدير لأن التقدير: (و الصّابئون كذلك).
و منها قوله فيها: اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً [ (2) البقرة: 162] و في إبراهيم: هَذَا الْبَلَدَ آمِناً [ (14) إبراهيم: 35] لأن الأوّل إشارة إلى غير بلد و هو الوادي قبل بناء الكعبة؛ و الثّاني: إشارة إليه بعد بنائها.
و منها قوله: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا [ (2) البقرة: 160] و ليس فيه: من بعد ذلك و هو في غيرها، لأنّ هنا «من بعد ما بيّناه» فأغنى عن إعادته.
و منها في بعض المسبّحات: سبّح- و في بعضها: يسبّح، و هي كلمة استأثر اللّه بها فأتى بها على جميع وجوهها- فذكر المصدر في أوّل الإسراء و الماضي و المضارع في المسبّحات، و الأمر في الأعلى.
و منها تكرار (شرّ) أربع مرّات في الفلق لأنّ كلّ شرّ من الأربعة المضاف إليه غير شرّ الآخر.
الفضل: ترك عطف الجمل، و الوصل: عطفها. فالأوّل: يكون لفقدان التّغاير و يسمّى: كمال الاتّصال ككون الثّانية تأكيدا للأولى كقوله تعالى: لا رَيْبَ فِيهِ [ (2) البقرة: 2] فإنّه لمّا بولغ في وصفه ببلوغه الدّرجة القصوى في الكمال بجعل المبتدأ (ذلك)
ص: 111
و تعريف الخبر باللّام- جاز أن يتوهّم السّامع قبل التّأمّل أنّه ممّا يرمى به جزافا فأتبع نفيا لذلك، و كقوله: هُدىً لِلْمُتَّقِينَ فإنّ معناه: أنّه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتّى كأنّه هداية محضة فهو معنى: ذلِكَ الْكِتابُ إذ معناه: الكتاب الكامل و المراد كماله في الهداية.
أو بدلا منها لعدم توفيتها بالمراد نحو: أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِينَ وَ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ [ (26) الشعراء: 132، 134] فإنّ المراد التّنبيه على نعم اللّه و الثّاني أوفى لدلالته عليها بالتّفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين.
أو بيانا نحو: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ [ (20) طه: 120] و يكون لفقد الجامع المشترك بين الجمل نحو: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ [ (2) البقرة: 6] فصل لكون ما قبله حديثا عن القرآن و صفاته و هذا حديث عن الكفار و صفاتهم.
و لاختلاف الجملتين خبرا و إنشاء، و جوّز النّحاة العطف في مثل ذلك كقوله تعالى:
وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ [ (2) البقرة: 25] في سورة البقرة و يسمّى هذا القسم و الّذي قبله عند أهل المعاني: كمال الانقطاع.
و من المقتضي للفصل: ألّا يقصد إعطاء الثّانية حكم الأولى نحو: وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [ (2) البقرة: 14، 15] لم يعطف: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على: إِنَّا مَعَكُمْ لأنّه ليس من مقولهم و لا على: (قالوا) لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف.
و كذا كونها جوابا لسؤال اقتضته الأولى و يسمّى: استئنافا بيانيا نحو: يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ [ (24) النور: 36، 37]، وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ [ (12) يوسف: 53] فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ [ (51) الذاريات: 25] أي: فما ذا قال؟
و أمّا الوصل فيكون للجامع نحو: يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ [ (4) النساء: 142] إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ [ (82) الانفطار: 13، 14]- وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا [ (7) الأعراف: 31]، لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً [ (2) البقرة: 83] أي لا تعبدوا و أحسنوا.
ص: 112
هو تخصيص صفة بأمر دون آخر، أو أمر بصفة دون أخرى، فهو قصر موصوف على صفة، و صفة على موصوف.
و له أدوات منها: النّفي و الاستثناء نحو: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ [ (3) آل عمران: 144] أي: لا يتعدّى إلى التّبرّي من الموت مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ [ (5) المائدة: 75] ألا لا يتعدّى إلى الألوهيّة، و يسمّى ذلك قصر إفراد، و يخاطب به من يعتقد الشّركة لقطعها إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ [ (43) الزخرف: 59] به من يعتقد أنّه إله فيسمّى قصر قلب.
و منها إنما نحو: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ [ (2) البقرة: 173] أي: ما حرّم إلّا ذلك دون ما ادّعوه من البحيرة و السّائبة و نحوهما قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ...
[الأعراف: 203] فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ [ (13) الرعد: 40]، إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللَّهِ [ (12) يوسف: 86].
و منها: غير نحو: هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ [ (35) فاطر: 3] و منها: التّقديم نحو:
إِيَّاكَ نَعْبُدُ [ (1) الفاتحة: 4]، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ [ (39) الزمر: 66].
و منها: أنّما بالفتح عند الزّمخشري و البيضاويّ و التّنّوخي: و مثّلوا بقوله: قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ [ (21) الأنبياء 108].
و منها: قلب حروف بعض الكلمة عند الزّمخشريّ أيضا و مثل له بقوله تعالى:
وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها [ (39) الزمر: 17] فإن القلب للاختصاص بالنسبة إلى لفظ «الطّاغوت» لأن وزنه: فعلوت من الطّغيان قلب بتقديم اللّام على العين فوزنه: فلعوت مبالغة.
و منها: أدوات أخر مختلف فيها و حرّرناها في كتبنا البيانيّة.
و أكثر ما تستعمل (إنّما) في مواقع التّعريض نحو: إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ [ (13) الرعد: 19] فإنّه تعريض بأنّ الكفّار من فرط جهلهم كالبهائم.
فائدة: أطلق النّاس أنّ الحصر هو الاختصاص، و اختار السّبكيّ التفرقة بينهما و صنّف في ذلك كتابا لطيفا قال فيه: الحصر: نفي غير المذكور و إثبات المذكور- و الاختصاص:
قصد الخاصّ من جهة خصوصه فيقدّم للاهتمام به من غير تعرّض لنفي غيره، قال: و إنّما جاء النّفي في: إِيَّاكَ نَعْبُدُ للعلم بأنّ قائليه لا يعبدون غير اللّه، و لذا لم يطّرد ذلك في
ص: 113
بقيّة الآيات، فإن قوله تعالى: أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ [ (3) آل عمران: 83] لو جعل في معنى ما يبغون إلّا غير دين اللّه و همزة الإنكار داخلة عليه لزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرّد بغيهم غير دين اللّه و ليس المراد. و كذلك أَ إِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ [ (37) الصافات: 86] المنكر إرادتهم آلهة دون اللّه من غير حصر انتهى، و هذا الّذي قاله هو التّحقيق.
هذا النّوع من زيادتي و هو لطيف، و لم نر أحدا من أهل المعاني و البيان، و البديع، و كنت تأمّلت قوله تعالى: لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَ لا زَمْهَرِيراً [ (76) الإنسان: 13] و القولين اللّذين في الزّمهرير، فقيل: هو القمر في مقابلة الشمس، و قيل: هو البرد فقلت: لعلّ المراد به البرد، و أفاد بالشّمس: أنّه لا قمر فيها، و بالزّمهرير: أنّه لا حرّ فيها فحذف من كلّ شقّ مقابل الآخر، و قلت في نفسي: هذا نوع من البديع لطيف لكنّي لا أدري ما اسمه و لا أعرف في أنواع البديع ما يناسبه حتّى أفادني بعض الأئمّة الفضلاء أنّه سمع بعض شيوخه قرّر له مثل ذلك في قوله تعالى: فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْرى كافِرَةٌ [ (3) آل عمران: 13] قال:
فأفاد بقوله: كافرة أنّ الفئة الأولى مؤمنة، و بقوله: تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أنّ الأخرى تقاتل في سبيل الطّاغوت قال: و هذا النّوع يسمّى بالاحتباك قال الإمام الفاضل المذكور:
و تطلّبت ذلك في عدّة كتب فلم أقف عليه، و أظنه في شرح الحاوي لابن الأثير، ثمّ صنّف المذكور في هذا النّوع تأليفا لطيفا سمّاه: الإدراك لفنّ الاحتباك.
ثمّ وقفت في التّبيان للطّيبيّ على ما يشبه هذا النّوع و سمّاه: الطّرد و العكس و قال:
هو أن يؤتى بكلامين يقرّر الأوّل بمنطوقه مفهوم الثّاني و بالعكس كقوله تعالى: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [ (24) النور: 58] فقوله: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ كلام مقرّر للأمر بالاستئذان في تلك الأوقات خاصة- فمنطوق الأمر بالاستئذان مقرر لمفهوم رفع الجناح و بالعكس.
قال: و كذا قوله تعالى: لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ [ (66) التحريم:
6] ثمّ وجدت هذا النّوع بعينه مذكورا في شرح بديعيّة أبي عبد اللّه بن جابر لرفيقه أحمد بن يوسف الأندلسي و هما المشهوران بالأعمى و البصير قال ما نصه: من أنواع البديع:
الاحتباك- و هو نوع عزيز- و هو أن يحذف من الأوّل ما أثبت نظيره في الثّاني و من الثّاني ما أثبت نظيره في الأوّل كقوله تعالى: وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ [ (2) البقرة:
ص: 114
171] الآية، و التّقدير: مثل الأنبياء و الكفّار كمثل الّذي ينعق و الّذي ينعق به فحذف من الأوّل: الأنبياء لدلالة الّذي ينعق عليه، و من الثّاني: الذي ينعق به لدلالة الّذين كفروا عليه.
و قوله: لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَ يُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا [ (18) الكهف: 2، 4] الآية، حذف من الأوّل مفعول: «لينذر» الأوّل و هو: «الّذين قالوا». و من الثّاني: مفعوله الثّاني و هو: «بأسا شديدا».
و قوله: وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ [ (27) النمل: 12] التّقدير: تدخل غير بيضاء، و أخرجها تخرج إلى آخره، فحذف من الأوّل، تدخل إلى آخره، و من الثّاني: و أخرجها انتهى ملخّصا.
هذا النّوع من زيادتي، و هو من فنون البديع، و ألّف الصّلاح الصّفديّ فيه تأليفا، و هو: أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شي ء أثبت له حكم فيثبتها لغيره من غير تعرّض لثبوته و انتفائه نحو: يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ [ (63) المنافقون: 8] فالأعزّ وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم و الأذلّ كناية عن المؤمنين، و قد أثبتوا لفريقهم المكنيّ عنه بالأعزّ الإخراج، فأثبت اللّه في الرّدّ عليهم صفة العزّة لغير فريقهم: و هو اللّه و رسوله و المؤمنون، و لم يتعرّض لثبوت ذلك الحكم الّذي هو الإخراج للموصوفين بالعزّة و هو اللّه و رسوله و المؤمنون، و لا لنفيه عنهم، كذا عرّفوه في البديع. و عرّفوه في الأصول بتسليم الدّليل مع بقاء النزاع، و بيانه هنا أن يقال: صحيح أنّ الأعزّ يخرج الأذلّ كما قلتم لكن اللّه و رسوله و المؤمنون هم الأعز المخرجون و أنتم الأذلّ المخرجون، فالدّليل و هو كون الأعزّ يخرج الأذلّ مسلّم، و لكنّ النّزاع بين اللّه و المنافقين في المتّصف به و هذا أدقّ من الأوّل.
هذا النّوع من زيادتي، و هي الجمع بين متقابلين في الجملة، و يكون بلفظين من نوع: اسمين نحو: وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ [ (18) الكهف: 18] أو فعلين نحو يُحْيِي وَ يُمِيتُ [ (57) الحديد: 2] أو حرفين نحو: لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ [ (2) البقرة:
286] أو نوعين نحو: أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ [ (6) الأنعام: 122].
و يكون مثبتا كما ذكر و منفيا نحو: فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ [ (5) المائدة: 44]
ص: 115
وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ [ (30) الروم: 6].
و يلحق به نحو: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ [ (48) الفتح: 29] فإنّ الرّحمة مسبّبة عن اللّين.
و منها نوع يخصّ باسم المقابلة و هو: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر بما يقابل ذلك على التّرتيب نحو: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً [ (9) التوبة: 82].
و نحو: يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ [ (7) الأعراف: 157].
و نحو: فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى [ (92) الليل: 6، 10]. فإنّ المراد باستغنى: أنّه زهد فيما عند اللّه كأنّه مستغن عنه فلم يتّق، أو استغنى بشهوات الدّنيا عن نعيم الآخرة فلم يتّق.
هذا النّوع من زيادتي و هو: ذكر الشّي ء و ما يناسبه، و يسمّى أيضا: مراعاة النّظير نحو: الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ [ (55) الرحمن: 5].
و منه نوع يسمّى: تشابه بالأطراف و هو: أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى نحو: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [ (6) الأنعام: 103] فإنّ الذي لا تدركه الأبصار يناسبه اللّطيف، و الّذي يدرك يناسبه الخبير.
و منه: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ [ (5) المائدة: 118] الآية.
قال الطّيبي: هو من خفيّ هذا القسم، لأنّ قوله: وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة: الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لكن التقدير: إن تغفر لمن يستحقّ العذاب فالمناسب له:
العزير الحكيم الّذي ليس فوقه أحد يردّ عليه حكمه و يعلم الحكمة فيما يفعله و إن خفيت.
و يحكى أنّ أعرابيا سمع قارئا يقرأ: (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البيّنات فاعلموا أنّ اللّه غفور رحيم) فأنكره و لم يكن قرأ القرآن و قال: إن كان هذا كلام اللّه فلا يقول كذا، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزّلل لأنّه إغراء عليه.
و منه نوع يسمّى: المشاكلة، و هو ذكر الشّي ء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، و هذا نوع مهمّ ينبغي إتقانه لأنّه كثير في القرآن نحو: تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي
ص: 116
نَفْسِكَ [ (5) المائدة: 116] فإطلاق النّفس على اللّه لمشاكلة ما قبله، و كذا قوله: إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [ (2) البقرة: 138، 139] وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ [ (3) آل عمران: 54]، وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [ (42) الشورى: 40].
و قد يذكر بلفظ غيره لتقدير وقوعه في صحبته نحو: صِبْغَةَ اللَّهِ فهو مصدر مؤكّد لآمنّا باللّه، أي: تطهير اللّه، لأنّ الإيمان يطهّر النّفس و الأصل، أنّ النّصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمّونه: المعموديّة و يقولون: إنّه تطهير لهم، فعبّر عن الإيمان باللّه «بصبغة اللّه للمشاكلة بهذه القرينة».
النّوع السّابع و السّبعون: المجانسة
هذا النّوع من زيادتي، و يطلق عليه: الجناس، و هو: تشابه اللّفظين و أقسامه كثيرة، و ألف فيه الصّلاح الصّفديّ تأليفا، و نذكر منه ما وقع في القرآن:
الأوّل: التّامّ، و هو أن يتّفق اللّفظان في أنواع الحروف و أعدادها، و هيئاتها، و ترتيبها.
ثمّ إن كانا من نوع كاسمين فهو مماثل نحو: وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ [ (30) الروم: 55] أو من نوعين سمّي مستوفى نحو: وَ إِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ [ (10) يونس: 21].
فإذا الأولى شرطيّة و هي اسم و الثّانية فجائيّة و هي حرف.
الثّاني: النّاقص: و هو أن يختلفا في العدد نحو وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ [ (75) القيامة: 29، 30].
الثّالث: اللّفظيّ: و هو أن يتفقا لفظا و يختلفا خطا نحو: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ [ (75) القيامة: 22، 23].
الرّابع: المضارع: و هو أن يختلفا في الحروف بمتقاربين نحو: وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ [ (6) الأنعام: 26].
الخامس: اللّاحق و هو: أن يختلفا بغير متقاربين نحو: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ [ (104) الهمزة: 1]، ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ [ (40) غافر: 75]، وَ إِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ [ (100) العاديات: 7، 8]
ص: 117
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ [ (4) النساء: 37].
السّادس: المصحّف و هو: أن تتفق الكلمتان خطا و تختلف نقط الحروف نحو:
وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً [ (18) الكهف: 104]، وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ [ (26) الشعراء: 79، 80].
السّابع: المحرّف و هو: أن يختلفا شكلا نحو: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ [ (37) الصافات: 72، 73]، وَ عَتَوْا عُتُوًّا [ (25 الفرقان: 21] و منه نوع يسمّى: المقلوب المستوي نحو: وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ [ (74) المدثر: 3] كُلٌّ فِي فَلَكٍ [ (36) يس: 40].
و يلحق بالجناس شيئان.
الأوّل: أن يجمع اللّفظين الاشتقاق نحو: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ [ (30) الروم:
43]، و سمّاه المتأخّرون: الجناس المطلق.
الثّاني: أن تجمعهما المشابهة، و هي ما يشبه الاشتقاق نحو: قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ [ (26) الشعراء: 168].
و إذا ولي أحد المتجانسين الآخر فهو المزدوج نحو: مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ [ (27) النمل: 22] أو وقع أحدهما في أول الآية و الآخر آخرها فهو: ردّ العجز على الصّدر كالآية الّتي قبله، و نحو: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً [ (27) نوح: 10] وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ [ (33) الأحزاب: 37].
و يقرب منه ما يسمّى بالعكس و هو: أن يقدّم في الكلام جزء ثم يؤخّر نحو: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ [ (30) الروم: 19]، لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [ (60) الممتحنة: 10].
النّوع الثّامن و السّبعون و التّاسع و السّبعون: التّورية و الاستخدام
هذان النّوعان من زيادتي، و أفردهما النّاس بالتّصنيف، و هما مهمان خصوصا التّورية.
قال الزّمخشريّ: لا نرى بابا في البيان أدقّ و لا ألطف من التّورية و لا أنفع و لا أعون على تعاطي المشتبهات في كلام اللّه و رسوله، و هي: أن يطلق لفظ له معنيان: قريب و بعيد، و يراد البعيد، ثمّ تارة تكون مجرّدة و هي الّتي لا تجامع شيئا ممّا يلائم القريب
ص: 118
نحو: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى [ (20) طه: 5] فإنّ الاستواء له معنيان: الاستقرار و هو المعنى القريب المورّى عنه لأنّه غير مقصود لتنزيه الحق عنه، الاستيلاء و هو البعيد المقصود المورّى عنه بالقريب.
و تارة تكون مرشّحة نحو: وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ [ (51) الذاريات: 47] فأيد تحتمل الجارحة و هو المورّى به، و قد ذكر ممّا يلائمه البناء، و يحتمل القوّة و القدرة و هو البعيد المقصود. و أمّا الاستخدام فلهم فيه تعريفان:
أحدهما: أن يذكر لفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه، ثمّ يؤتى بضميره مرادا به المعنى الآخر كقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى [ (4) النساء: 43] الآية.
فالصّلاة يحتمل أن تكون: فعل الصّلاة و موضع الصّلاة، فأراد الأوّل بلفظها لقرينة:
حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ و الثّاني بقوله: إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ.
الثّاني: أن يؤتى بلفظ مشترك، ثمّ بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين و من الآخر الآخر كقوله تعالى: لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ [ (13) الرعد: 38] الآية، فلفظ «كتاب» يحتمل الأمد المحتوم، و الكتاب المكتوب و لفظ (أجل) يخدم المعنى الأوّل، و (يمحو) يخدم المعنى الثّاني.
النّوع الثّمانون: اللّفّ و النّشر
هذا النّوع من زيادتي و هو: أن يذكر متعدّد على التّفصيل أو الإجمال ثمّ ما لكلّ من غير تعيين ثقة بأنّ السّامع يردّه إليه.
ثمّ هو ثلاثة أقسام:
أحدها: المرتّب نحو: وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ [ (28) القصص: 73].
و قوله: مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَ الْأَصَمِّ وَ الْبَصِيرِ وَ السَّمِيعِ [ (11) هود: 24].
الثّاني: المعكوس نحو: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ [ (3) آل عمران: 106] الخ.
الثّالث: المشوّش و لا أستحضر الآن في القرآن مثاله.
ص: 119
النّوع الحادي و الثّمانون: الالتفات
هذا النّوع من زيادتي و هو: الانتقال من التّكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر تطرية للكلام و تفنّنا في الأسلوب مثاله من التكلّم إلى الخطاب: وَ ما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [ (36) يس: 22] و مقتضى السياق: و إليه أرجع و إلى الغيبة: إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [ (108) الكوثر: 1، 2] إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [ (44) الدخان: 5، 6].
و مثاله من الخطاب إلى التّكلّم لم أجده في القرآن.
و إلى الغيبة: حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ [ (10) يونس: 22]، وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ [ (21) الأنبياء: 92، 93].
و مثاله من الغيبة إلى التّكلّم: وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ [ (35) فاطر: 9]، وَ أَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها [ (41) فصلت: 12].
و إلى الخطاب: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ [ (1) الفاتحة: 3، 4].
و قد يكون في الآية التفاتان و أكثر نحو: إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ [ (48) الفتح: 8، 9] ففيه التفاتان:
أحدهما: بين «أرسلنا» و الجلالة.
و الثّاني: بين الكاف في «أرسلناك» و رسوله.
و ذكر التّنوخيّ و ابن الأثير منه: بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلّمه نحو:
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ بعد: (أنعمت) فإنّ المعنى: غير الّذين غضب عليهم و هو نوع غريب و يقرب من الالتفات: الانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى خطاب الآخر، و ليس هو منه لأنّه ليس فيه انتقال من أحد الأساليب الثّلاثة الّتي هي: التّكلّم و الخطاب و الغيبة إلى آخره.
مثاله من خطاب الواحد إلى الاثنين: أَ جِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَ تَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ [ (10) يونس: 78]، و إلى الجمع: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ [ (65) الطلاق: 1].
و مثاله من الاثنين إلى الواحد: فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى [ (20) طه: 49]، و إلى الجمع: وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَ أَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً [ (10) يونس: 87].
ص: 120
و مثاله من الجمع إلى الواحد: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ و إلى الاثنين: يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ إلى قوله: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ [ (55) الرحمن:
33، 34].
و قد سبق في المجاز نوع يشبه هذا و ليس هو هو، لأنّ هناك استعمل أحد الثّلاثة في غيره، و هنا استعمل كلّ في موضوعه، لكنّه انتقل من شي ء إلى شي ء فهو حقيقة، و كذا الالتفات فهذه الثّلاثة أنواع متقاربة في الجنس و المعنى مستوية في الأقسام.
هذا النّوع من زيادتي، و الفواصل: أواخر الآي و هي: جمع فاصلة و تسمّى في غير القرآن: السّجع، و لا يطلق ذلك على القرآن تأدّبا. و الفاصلة إن اختلفت مع قرينتها في الوزن لا في التّقفية فهو المطرّف نحو: ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً [ (71) نوح: 13، 14].
و إن اتّفقتا فمتواز نحو: فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَ أَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ [ (88) الغاشية:
13، 14]. و أحسنه: ما تساوت قرائنه نحو: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ [ (56) الواقعة 28، 30] ثم ما طالت قرينته الثّانية نحو: وَ النَّجْمِ إِذا هَوى ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى [ (53) النجم: 1، 2]، أو الثّالثة نحو: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ [ (69) الحاقة: 30، 32].
و إن تساوت الفاصلتان في الوزن دون التّقفية فموازنة نحو: وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَ زَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ [ (88) الغاشية: 15، 16].
فإن كان ما في إحدى القرينتين أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى فمماثلة نحو:
وَ آتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ. وَ هَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ [ (37) الصافات: 117، 118].
و إن اتّفقتا في الحرف الّذي قبل الأخير فلزوم ما لا يلزم نحو: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ [93 الضحى: 9، 10] و آيات سورة أَ لَمْ نَشْرَحْ.
و أمّا الغايات فهي: أواخر السّور، و القصد بذلك: أن آخر كلّ سورة أتى على الوجه الأكمل و النّمط الأبلغ في براعة الانتهاء. و ما ينبغي أن يختم به.
ص: 121
النّوع الثّالث و الرّابع و الخامس و الثّمانون: أفضل القرآن و فاضله و مفضوله
هذه الأنواع من زيادتي، و يشبهها من علم الحديث: الكلام على أصحّ الأسانيد:
و اختلف في تفاضل بعض الآيات و السّور على بعض فذهب كثيرون إلى القول به منهم:
إسحاق به راهويه، و أبو بكر بن العربي، و الشّيخ عزّ الدّين بن عبد السّلام.
و قال القرطبي: إنّه الحقّ و نقله عن جماعة من العلماء و المتكلّمين.
و قال ابن الحصّار: العجب ممّن يذكر الاختلاف في ذلك مع النّصوص الواردة بالتّفصيل، قال البيهقي في شعب الإيمان: قال الحليمي: و معنى التّفضيل يرجع إلى أشياء:
أحدها: أن يكون العمل بآية أولى من العمل بأخرى و أعود على النّاس، و على هذا يقال: آيات الأمر و النّهي، و الوعد و الوعيد خير من آيات القصص لأنّها إنّما أريد بها تأكيد الأمر و النّهي و الإنذار و التّبشير و لا غنى بالنّاس عن هذه الأمور، و قد يستغنون عن القصص، فكان ما هو أعود عليهم و أنفع لهم ممّا يجري مجرى الأصول خيرا لهم ممّا يجعل تبعا لما لا بدّ منه.
الثّاني: أن يقال: الآيات الّتي تشتمل على تعديد أسماء اللّه و بيان صفاته و الدّلالة على عظمته أفضل، بمعنى أنّ مخبراتها أسنى و أجلّ قدرا و على هذا نحا ابن عبد السّلام في قوله الآتي.
الثّالث: أن يقال: إنّ سورة خير من سورة، أو آية خير من آية، يعني أنّ القارئ يتعجّل له بقراءتها فائدة سوى الثّواب الآجل و يتأدّى منه بتلاوتها عبادة، كقراءة آية الكرسي و الإخلاص و المعوّذتين فإنّ قارئها يتعجّل بقراءتها الاحتراز ممّا يخشى و الاعتصام باللّه، و يتأدّى بتلاوتها عبادة اللّه لما فيها من ذكره سبحانه بالصّفات العلى على سبيل الاعتقاد لها و سكون النّفس إلى فضل ذلك الذّكر.
و ذهبت طائفة إلى أنّه لا تفاضل لأنّ الجميع كلام اللّه و لئلّا يوهم التّفضيل نقص المفضّل عليه.
و نقل عن الأشعريّ و الباقلانيّ و ابن حبّان و روي عن مالك و على الأوّل: قال الشّيخ عزّ الدين بن عبد السّلام: القرآن على قسمين: فاضل و هو كلام اللّه في اللّه و مفضول و هو:
ص: 122
كلامه عن غيره كقوله تعالى حكاية عن فرعون: ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي [ (28) القصص: 38] و كحكايته عن الكفّار و نحو ذلك.
قلت: بل هو ثلاثة أقسام: أفضل، و فاضل، و مفضول لأنّ كلامه تعالى فيه بعض أفضل من بعض كتفضيل الفاتحة و الإخلاص كما سنذكره.
و قد ثبت في الصّحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى: «أعظم سورة في القرآن الفاتحة»، و كذا رواه التّرمذيّ من حديث أبي هريرة و أبيّ، و أحمد من حديث عبد اللّه بن جابر العبدي و لفظه: «أخير سورة في القرآن».
و في صحيح مسلم و غيره من طرق مرفوعا: «أعظم آية في القرآن آية الكرسيّ».
و روى ابن خزيمة و البيهقيّ و غيرهما عن ابن عبّاس: «أعظم آية في القرآن البسملة».
و عند التّرمذيّ: «سيّدة آي القرآن آية الكرسيّ، و سنام القرآن سورة البقرة، و قلب القرآن يس».
و كذا وردت أحاديث مشعرة بالتّفضيل، ككون: «الإخلاص» تعدل ثلث القرآن.
و ذكر في حكمة ذلك أنّ القرآن توحيد و أحكام و وعظ، و سورة الإخلاص فيها التّوحيد كلّه.
و في مسند عبد بن حميد: أنّ الفاتحة تعدل ثلثيه و في المستدرك أحاديث: أنّ الزّلزلة تعدل نصفه، و الكافرين تعدل ربعه، و المعوّذتين تعدل ثلثه، و ألهاكم تعدل ألف آية و عند الترمذي: إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ تعدل ربعه.
هذا النّوع من زيادتي و هو نوع لطيف قريب ممّا قبله: أعظم آية في القرآن آية الكرسيّ أو البسملة كما تقدّم، و الجمع بينهما قريب. أعظم سورة الفاتحة، أطول آية فيه آية الدّين.
أجمع آية: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ [ (16) النحل: 90]، رواه البيهقي في الشّعب و أبو عبيد في الفضائل عن ابن مسعود. و روي عنه أنّه قال: ما في القرآن آية أعظم فرجا من آية في سورة الغرف: قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ [ (39) الزمر: 53] الآية. و قال: ما في القرآن آية أكثر تفويضا من آية في سورة النّساء القصرى: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [ (65) الطلاق: 6] الآية.
ص: 123
و روى عبد الرّزّاق في تفسيره أنّ ابن مسعود قال: أعدل آية في القرآن: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ الآية.
و أحكم آية: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ [ (99) الزلزلة: 7، 8] الآيتين.
و روى أبو عبيد عن صفوان بن سليم و محمد بن المنكدر قالا: التقى ابن عبّاس و ابن عمرو فقال ابن عبّاس: أيّ آية في كتاب اللّه أرجى؟ فقال عبد اللّه بن عمرو: قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ الآية، فقال ابن عبّاس: لكن قول اللّه: وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي [ (2) البقرة: 260] قال: فرضي منه بقوله: (بلى)، قال: فهذا لما يعترض في الصّدر ممّا يوسوس به الشّيطان، أخرجه الحاكم في المستدرك.
و أخرج أبو نعيم في الحلية عن عليّ أنّه قال: إنّكم يا معشر أهل العراق تقولون:
أرجى آية في القرآن: قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ ... الآية، لكنّا أهل البيت نقول: إنّ أرجى آية في كتاب اللّه: وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى [ (93) الضحى: 5] و هي: الشفاعة.
و أخوف آية قيل قوله: أَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ [ (70) المعارج:
38]، و عندي أنّها قوله تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً [ (18) الكهف: 103، 104].
و روى عبد الرّزّاق عن ابن مسعود أنّها: مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ [ (4) النساء: 113] و في البخاري قال سفيان: ما في القرآن آية أشدّ عليّ من: لَسْتُمْ عَلى شَيْ ءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ [ (5) المائدة: 68].
و روى أحمد في مسنده عن عليّ قال: أ لا أخبركم بأفضل آية في كتاب اللّه حدّثنا بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [ (42) الشورى: 30] و سأفسّرها لك يا عليّ: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدّنيا فبما كسبت أيديكم و اللّه أكرم من أن يثنّي العقوبة، و ما عفا اللّه عنه في الدّنيا فاللّه أحلم من أن يعود بعد عفوه.
و قال البلقيني في أوّل كتابه: قد قيل إنّ سورة الحجّ من عجيب القرآن فيها مكّيّ و مدنيّ و حضريّ و سفريّ و ليليّ و نهاريّ و حربيّ و سلميّ و ناسخ و منسوخ. انتهى.
ص: 124
و قد ذكر هذا الكلام محمّد بن بركات السّعيدي النّحوي في كتابه في النّاسخ و المنسوخ و قال: المكّيّ منها: من رأس الثّلاثين إلى آخرها- و المدني: من رأس خمس عشرة إلى رأس الثّلاثين و اللّيليّ: خمس آيات من أوّلها- و النّهاريّ: من رأس تسع آيات إلى رأس اثنتي عشرة، و الحضريّ: إلى رأس العشرين.
قلت: و السّفريّ أوّلها كما تقدّم، و النّاسخ: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ [ (22) الحج: 29] الآية، و المنسوخ: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ [ (22) الحج: 52] الآية. نسخها: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى [ (87) الأعلى: 6] و قوله: اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ [ (22) الحج: 69] الآية نسختها آية السّيف.
هذا النّوع من زيادتي، و للناس في أمثال القرآن تصانيف منهم الإمام أبو الحسن الماوردي.
روى البيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «إنّ القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال و حرام و محكم و متشابه و أمثال، فاعملوا بالحلال، و اجتنبوا الحرام، و اتّبعوا المحكم، و آمنوا بالمتشابه، و اعتبروا بالأمثال».
و لقد قال تعالى: وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ [ (39) الزمر: 27] و من أمثال القرآن ما صرّح فيه بذكر المثل و هو الأغلب.
و منها ما لم يصرّح فيه بذكر المثل و لكنّها كامنة فيه، كما حكى الماوردي أنّ بعضهم سئل فقيل له: إنّك تخرج أمثال العرب و العجم من القرآن فهل تجد في كتاب اللّه: «خير الأمور أوساطها» فقال: نعم في أربعة مواضع، في قوله: لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ [ (2) البقرة: 68] و قوله: وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً [ (25) الفرقان: 67]، و قوله: وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا [ (17) الإسراء: 110]، و قوله: وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ [ (17) الإسراء: 29].
فقيل له: هل تجد فيه: من جهل شيئا عاداه؟ قال: نعم في قوله: بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ [ (10) يونس: 39]، و قوله: وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ [ (46) الأحقاف: 11].
ص: 125
فقيل له: هل تجد فيه: احذر شرّ من أحسنت إليه؟ قال: نعم في قوله: وَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ [ (9) التوبة: 84].
فقيل له: فهل تجد فيه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين؟ قال: نعم في قوله تعالى: هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ [ (12) يوسف: 64].
فقيل له: هل تجد فيه: من أعان ظالما سلّط عليه؟ قال: نعم في قوله تعالى:
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ [ (22) الحج: 4].
و سئل بعضهم: أين تجد في القرآن: الحبيب لا يعذّب حبيبه؟ فقال: في قوله تعالى: وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ [ (5) المائدة: 18].
هذان النّوعان من زيادتي، و يشبههما من علم الحديث: آداب المحدّث و آداب طالب الحديث، و للنّاس في ذلك تصانيف أشهرها: التّبيان للنّوويّ، و مختصره له، و أنا أشير هنا إلى مقاصده حاذفا معظم الأدلّة اختصارا.
فعلى كلّ من القارئ و المقرئ: إخلاص النّيّة، و قصد وجه اللّه، و أن لا يقصد بتعلّمه أو بتعليمه غرضا من الدّنيا كرئاسة أو مال. و لا يشين المقرئ إقراؤه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، و لا التكثّر بكثرة المشتغلين عليه و المترددين إليه، و لا يكره قراءة أصحابه على غيره- و يتخلّق بآداب القرآن و يقف عند حدوده و أوامره و نواهيه، و يعمل بمكارم الأخلاق المرضية من الزّهد في الدّنيا و عدم الالتفات إليها و إلى أهلها، و الجود و طلاقة الوجه و السّكينة و الوقار و الخضوع و اجتناب الضّحك و كثرة المزاح، و التّنظّف بإزالة الأوساخ و الشّعر و الظّفر و الرّيح الكريه و تسريح اللّحية و دهنها و المحافظة على الطّهارة و اتّباع الأحاديث الواردة بالأذكار و فضائل الأعمال و التّبرّي من أمراض القلوب كالحسد و الرّياء و العجب و التكبر، و إن كان غيره دونه، و أن لا يرى نفسه خيرا من أحد، و يرفق بطلبته، و يرحّب بهم و يحسن إليهم بحسب حاله و حالهم، و ينصحهم ما استطاع، و يتواضع لهم و يحرّضهم على التعلّم و يؤلّفهم عليه، و يعتني بمصالحهم و يصبر على بطي ء الفهم و يعذر من قلّ أدبه في بعض الأحيان و يعرّفه ذلك بلطف، لئلّا يعود إلى مثله، و يعوّدهم بالتّدريج بالآداب السّنية، و يأخذهم بإعادة محفوظاتهم- و يثني على من ظهرت
ص: 126
نجابته ما لم يخش عليه الإعجاب- و يعنّف من قصّر تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيره، و يقدّم في تعليمهم السّابق فالسّابق، و لا يمكّنه من إيثاره بنوبته إلّا لمصلحة شرعيّة، فإنّ الإيثار في القرب مكروه، و يتفقّد أحوالهم، و يسأل عن غائبهم، و لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النّيّة، و يصون يديه حال الإقراء عن العبث و عينيه و أذنيه عن النّظر و السّمع لغير القارئ، و يقعد متطهّرا مستقبل القبلة في ثياب بيض نظيفة، و إذا وصل لموضع جلوسه صلّى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكّد، و ليكن مجلسه حسنا واسعا، و لا يذلّ العلم فيذهب إلى موضع ينسب إلى من يتعلّم منه فيعلّمه فيه و لو كان خليفة فمن دونه.
و على المتعلّم أن يجتنب الأسباب الشّاغلة عن العلم إلّا ما لا بدّ منه و يطهّر قلبه و يتواضع لمعلّمه و إن كان أصغر سنا منه أو أقلّ شهرة، و ينقاد له و يقبل قوله كالمريض مع الطّبيب النّاصح الحاذق.
و لا يتعلّم إلّا ممّن تأهّل و ظهر دينه و صيانته، فالعلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم. و ينظر إلى معلّمه بعين الاحترام و التّعظيم، و لا يدخل عليه بلا إذن إلّا إن كان بموضع لا يحتاج إلى استئذان، و يسلّم على الحاضرين، و يخصّه بزيادة تودّد، و يسلّم عند انصرافه أيضا، و لا يتخطى النّاس، و يجلس حيث انتهى به المجلس إلّا أن يأذن له الشّيخ في التّقدّم، و لا يقيم أحدا و يجلس موضعه، و لا يجلس وسط الحلقة، و لا بين صاحبين بغير إذنهما، و لا يغمز بعينه عند الشّيخ، و لا يقول له: قال فلان بخلاف قولك، و لا يغتاب عنده أحدا، و لا يلحّ عليه إذا كسل، و لا يشبع من طول صحبته، و يردّ غيبة شيخه إذا قدر، و لا يفارق ذلك المجلس، و يتأدّب مع رفقائه، و لا يحسد أحدا منهم، و لا يعجب بما حصّله، و لا يرفع صوته بلا حاجة عند الشّيخ، و لا يضحك، و لا يكثر الكلام، و لا يعبث بيده، و لا يلتفت بلا حاجة، بل يتوجّه إلى الشّيخ، و لا يقرأ على الشّيخ في حال ملله، و يحتمل جفوة الشّيخ و سوء خلقه، و إذا جفاه ابتدأ هو بالاعتذار و إظهار الذّنب له، و إذا صدر من الشّيخ أفعال ظاهرها منكر أوّلها و لا ينكرها.
و ممّا يشترك فيه القارئ و المقرئ: الحذر من اتّخاذ القرآن معيشة يتكسّب بها، نعم يجوز عند الشّافعي و مالك أخذ الأجرة على تعليمه، و ملازمة التّلاوة، و الإكثار منها، و نسيانه كبيرة، و إذا أراد القراءة استاك و توضّأ، فإن قرأ محدثا جاز بلا كراهة.
و يحرم مسّ المصحف و القراءة على الجنب و الحائض، و يجوز لهما النّظر في المصحف، و إمرار القرآن على قلبيهما، و يسنّ أن يقرأ في مكان نظيف، و لا يكره في الحمّام عندنا، و لا في الطّريق، و يستقبل القبلة، و يجلس بخشوع و سكينة و حضور قلب،
ص: 127
و لا يكره قائما و لا مضطجعا، و يستعيذ، و أفضل ألفاظ الاستعاذة: أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم، و لو تعوّذ بغير ذلك أجرأه، و يتدبّر القرآن.
و تقدّمت كيفيّات القراءة في كيفيّة التّحمّل، و يبكي عند القراءة، فإن لم يبك تباكى، و إذا مرّ بآية رحمة سأل من فضل اللّه أو عذاب استعاذ أو تنزيه نزّه أو تفكّر تفكر، و يقرأ على ترتيب المصحف، و يجوز مخالفته إلّا أن يقرأ السورة معكوسا فلا، و القراءة في المصحف أفضل، لأنّ النّظر فيه عبادة، و الجهر، إلّا إذا خاف الرّياء.
و يسنّ تحسين الصّوت به ما لم يخرج إلى حدّ التّمطيط و الإفراط بزيادة حرف أو إخفائه أو مدّ ما لا يجوز مدّه فحرام، و يراعي الوقف عند تمام الكلام و لا يتقيّد بالأحزاب و الأعشار، و يقطع القراءة إذا نعس أو ملّ أو عرض له ريح حتّى يتمّ خروجها، أو تثاؤب حتّى ينقضي، و إذا قرأ نحو: وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ [ (5) المائدة: 64]، وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً [ (19) مريم: 88] خفض بها صوته.
و يتأكّد الاعتناء بسجود التّلاوة و هي أربع عشرة عندنا و محالّها معروفة، و إنّما اختلف في الّتي في (حم)، و الأصحّ عندنا أنّها عند قوله: وَ هُمْ لا يَسْأَمُونَ [ (41) فصلت: 38] و الّتي في النّمل و الأصحّ عندنا أنّها عند رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [ (27) النمل: 26] و تحرم القراءة بغير العربيّة مطلقا للقادر و غيره، و لا يكره النّفث معه للرقية و لا أن يقول: قراءة أبي عمرو و قراءة فلان، و كرههما بعض السّلف، و يكره أن يقول: نسيت آية كذا بل أنسيت و لبعض مسائل هذا الباب تتمّات مبسوطة في كتب الفقه.
هذا النّوع من زيادتي، قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أوّلا من القرآن، فإنّ ما أجمل في مكان قد فسّر في مكان آخر، فإن أعياه ذلك طلبه في السّنّة فإنّها شارحة للقرآن و موضّحة له.
و قد قال الإمام الشّافعيّ: كلّ ما حكم به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فهو ممّا فهمه من القرآن، قال تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ [ (4) النساء:
105] في آيات أخر، و في الحديث: «ألا إنّي أوتيت القرآن و مثله معه» يعني السّنّة، و فيه:
كان جبريل ينزل بالسّنّة كما ينزل بالقرآن. و أمّا حديث عائشة الّذي رواه البزّار و ابن جرير:
«ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يفسّر شيئا من القرآن إلّا آيات بعدد علّمهن إيّاه جبريل» فهو حديث منكر و إن أوّله ابن جرير.
فإن لم يجده في السّنّة رجع إلى أقوال الصّحابة فإنّهم أدرى بذلك لما شاهدوه من
ص: 128
القرائن و الأحوال عند نزوله، و لما اختصّوا به من الفهم التّامّ و العلم الصّحيح و العمل الصّالح، فإن لم يجد عن أحد من الصّحابة رجع إلى أقوال التّابعين، و ربّما وقع في عباراتهم تباين في الألفاظ فحسبها بعض من لا فطنة له اختلافا فيحكيها أقوالا و ليس كذلك، فإنّ منهم من يعبّر عن الشّي ء بلازمه أو بنظيره، و منهم من ينصّ على الشي ء بعينه، و الكلّ بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطّن اللّبيب لذلك.
و أمّا قول سعيد بن الحجّاج: أقوال التّابعين في الفروع غير حجّة فكيف تكون حجّة في التّفسير؟ فمعناه أنها لا تكون حجّة على غيرهم ممّن خالفهم و هو صحيح. أمّا إذا أجمعوا على الشّي ء فلا يرتاب في كونه حجّة، فإن اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجّة على بعض و لا على من بعدهم، و يرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السّنّة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصّحابة.
و عليه أن يستحضر الحديث الّذي رواه ابن جرير عن ابن عبّاس مرفوعا قال:
«التّفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، و تفسير لا يعذر أحد بجهالته، و تفسير يعلمه العلماء، و تفسير لا يعلمه إلّا اللّه». ثمّ رواه مرفوعا بسند ضعيف بلفظ: «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال و حرام لا يعذر أحد بجهالته، و تفسير تفسّره العرب، و تفسير تفسّره العلماء، و متشابه لا يعلمه إلّا اللّه، و من ادّعى علمه سوى اللّه فهو كاذب».
و عليه أن يكثر من الأقوال المحملة البعيدة و التّفاسير الغريبة، و ألا يتكلّف في حمل الآية على مذهبه إذا كان ظاهرها يخالفه، ففي الحديث (مراقي القرآن كفر) و أن يرجّح من الأقوال ما وافق قراءة أخرى كقوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ [ (5) المائدة: 6] فتفسير الملامسة بالمسّ باليد أولى من الجماع لموافقته للقراءة الأخرى: (أو لمستم) و يحرم تحريما غليظا أن يفسّر القرآن بما لا يقتضيه جوهر اللّفظ كما فعل ابن عربيّ المبتدع الّذي ينسب إليه كتاب «الفصوص» الّذي هو كفر كلّه.
و كما يحكى عن بعض الملحدة أنّه قال في قوله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ [ (2) البقرة: 255] إنّ معناه: من ذلّ- أي من الذّلّ- «ذي» إشارة للنّفس- «يشف» جواب «من» من الشّفا- «ع» فعل أمر من الوعي.
و يحرم أن يخرّج القرآن على القواعد المنطقيّة، و قد اتّفق أهل عصرنا ممّن يبيح المنطق منهم و من يحرّمه على التّغليظ على بعض العجم، و قد خرّج بعض آيات القرآن عليه و أفتوا بتعزيره و زجره و أنّه أتى بابا من العظائم، و إذا أعرب آية أعربها على أظهر
ص: 129
محتملاتها و أرجحها، و لا يذكر كلّ ما تحتمله و إن كان بعيدا جائزا إلّا لقصد التّمرين، و لا يذكر الأقاصيص الّتي لا يدري صحّتها خصوصا الإسرائيليّات، و ليقتصر منها على ما تدعو الضّرورة إليه إذا كان في الآية إشارة إليه متحرّيا أصحّ ما ورد و سيأتي حكم التّفسير بالرّأي.
هذا النّوع من زيادتي. و يشبهه من علم الحديث: معرفة من تقبل روايته و من لا تقبل.
قد تقدّم في آداب المفسّر أنّ التّفسير يطلب أوّلا من القرآن ثمّ السّنّة ثمّ أقوال الصّحابة و التّابعين، فناقل ذلك عنهم شرطه شروط الرّواية و هي: العدالة و الحفظ و الإتقان و هو مقدّر في علم الحديث، و كذا رجال القرآن لما تقدّم من أن أحد أركانه صحّة السّند.
و صحّ عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و عن الصّحابة أنّ التّفسير بالرّأي حرام، و تقدّم في المقدّمة الفرق بينه و بين التأويل.
فأمّا الأوّل فحرام مطلقا لما فيه من الشهادة على اللّه و القطع بأنّه مراده.
و أمّا الثّاني: و هو التّأويل فقد اختلف في جوازه فمنعه قوم سدّا للباب و تمسّكا بظاهر الحديث، و جوّزه آخرون لمن كان عالما بعلوم:
أحدها: اللّغة لأنّ بها معرفة شرح مفردات الألفاظ و مدلولاتها.
الثّاني: النّحو لأنّ المعنى يتغيّر و يختلف باختلاف الإعراب فلا بدّ من اعتباره.
الثّالث: التّصريف لم يذكره بعضهم و هو الأصوب، و وجه من ذكره أنّ به تعرف الأبنية و الصّيغ.
الرّابع: الاشتقاق لأنّ الاسم إذا كان اشتقاقه من مادّتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهما، كالمسيح هل هو من السّياحة أو المسح.
الخامس: المعاني لأنّ به تعرف خواصّ تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى.
السّادس: البيان لأنّ به تعرف خواصّ التّراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدّلالة و خفائها.
السّابع: البديع لأنّ به تعرف وجوه تحسين الكلام.
الثّامن: علم القراءات لأنّ به تعرف كيفيّة النّطق بالقرآن، و بالقراءات ترجّع بعض الوجوه المحتملة على بعض.
ص: 130
التّاسع: علم أصول الدّين لما في القرآن من الآيات الدّالة بظاهرها على ما لا يجوز على اللّه فالأصوليّ يؤول ذلك و يستدلّ على ما يستحيل و ما يجب و ما يجوز.
العاشر: أصول الفقه لأنّ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام و الاستنباط.
الحادي عشر: أسباب النّزول و القصص إذ بسبب النّزول يعرف معنى الآية المنزّلة فيه بحسب ما أنزلت فيه.
الثّاني عشر: النّاسخ و المنسوخ ليعلم المحكم من غيره.
الثّالث عشر: علم الفقه.
الرّابع عشر: الأحاديث المبيّنة لتفسير المجمل و المبهم.
الخامس عشر: علم الموهبة و هو علم يورّثه اللّه لمن عمل بما علم، و إليه الإشارة بحديث: «من عمل بما علم أورثه اللّه علم ما لم يعلم».
قال ابن أبي الدّنيا: و علوم القرآن و ما يستنبط منه بحر لا ساحل له.
قال: فهذه العلوم الّتي هي كآلة للمفسّر لا يكون مفسّرا إلّا بتحصيلها فمن فسّر بدونها كان مفسّرا بالرّأي المنهيّ عنه، و إذا فسّر مع حصولها لم يكن مفسّرا بالرّأي المنهيّ عنه.
قال: و الصّحابة و التّابعون كان عندهم علوم العربيّة بالطّبع لا بالاكتساب، و استفادوا العلوم الأخرى من القرآن و السّنن الّتي تلقفوها من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم.
قلت: و لهذا كان علم التّفسير الموضوع فيه هذا الكتاب مستمدّا من هذه العلوم، و أنواعه مأخوذة منه. و من أتقن الأنواع المذكورة في هذا الكتاب حصل له من ذلك ما يرومه و لم يحتج معه إلى غيره.
و لعلّك تستشكل علم الموهبة و تقول: هذا هو شي ء ليس في قدرة الإنسان تحصيله و ليس كما ظننت من الإشكال، و قد خطر لي تشبيهه بقولهم في حدّ المجتهد: هو فقيه النّفس، أي: شديد الفهم بالطّبع لمقاصد الكلام بحيث يقدر على الاستنباط.
و ممّن لا يقبل تفسيره: المبتدع خصوصا الزّمخشريّ في كشّافه فقد أكثر فيه من إخراج الآيات عن وجهها إلى معتقده الفاسد بحيث يسرق الإنسان من حيث لا يشعر و أساء فيه الأدب على سيّد المرسلين صلّى اللّه عليه و سلّم في مواضع عديدة فضلا عن الصّحابة و أهل السّنّة.
و قد أحسن الذّهبيّ إذ ذكره في الميزان، و قال: كن حذرا من كشّافه، و ألّف الشّيخ
ص: 131
تقيّ الدّين السّبكي كتابا سمّاه: الانكفاف عن إقراء الكشّاف، ذكر فيه أنّه عقد التّوبة من إقرائه و تاب إلى اللّه فلا يقرأه و لا ينظر فيه أبدا لما حواه من الإساءة المذكورة.
قال: و قد استشارني بعض أهل المدينة النّبويّة أن يشتري منه نسخة و يحملها إلى المدينة فأشرت عليه بأن لا يفعل حياء من النبي صلّى اللّه عليه و سلّم أن ينقل إلى بلد هو فيها كتاب فيه ما يتعلّق بجنابه صلّى اللّه عليه و سلّم- على أنّه آية في بيان أنواع البلاغة و الإعجاز لو لا ما شأنه ممّا ذكرناه.
و في تفسير البيضاويّ بحمد اللّه غنية في هذا الباب.
و لا يقبل من عرف بالجدال و المراء و التّعصّب لقول قاله و عدم الرّجوع إلى الحقّ إذا ظهر له، و لا من يقدّم الرّأي على السّنّة، و لا من عرف بالمجازفة و عدم التّثبّت أو بالجرأة و الإقدام على اللّه و قلّة المبالاة. و من المطعون فيهم: جبير، و العوفي، و الكلبي و مقاتل، و السّدّي الصغير و هو: محمد بن مروان بخلاف الكبير و اسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن.
ثمّ إنّ التّفسير عن ترجمان القرآن ابن عبّاس ورد من طرق، فمن جيّدها: طريق سعيد ابن منصور عن نوح بن قيس عن عثمان بن محصّن عنه، و طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه هكذا بالتّرديد و ربّما يجزم بأحدهما في بعض الرّوايات. و طريق مالك بن إسماعيل عن قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد عنه و من واهيها: طريق الكلبي عن أبي صالح، و طريق الضّحّاك عنه منقطعة لأنه لم يثبت سماعه منه بل قيل: و طريق علي بن أبي طلحة كذلك و إنه إنما سمع التّفسير من مجاهد أو سعيد عنه.
هذا النّوع من زيادتي، و هو يشبه من علم الحديث: المنكر أو الغريب و المراد به:
ما قيل في القرآن من الأقوال الغريبة لا يحلّ حمل القرآن عليها و لا ذكرها إلا على سبيل التّحذير منها.
و ألّف فيه بعض المتقدّمين كتابا في مجلّدين و هو: محمود بن حمزة الكرماني في حدود الخمسمائة، فمنها قوله تعالى:
وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ [ (2) البقرة: 286] قال قوم: يعني العشق و قوله تعالى:
وَ لَها عَرْشٌ عَظِيمٌ [ (27) النمل: 23] قال قوم: فرج عظيم. و قوله تعالى: وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ [ (113) الفلق: 4] قال بعضهم: أي من شرّ الذّكر إذا قام. و قوله تعالى:
ص: 132
حم عسق [أول الشورى] قال بعضهم: هو رجل يقال له: أبو عبد اللّه ينزل على نهر من أنهار المشرق يبتني عليه مدينتين و نحو ذلك.
و هذه أمثلة منها ليحذرها المفسّر و لا يعوّل عليها و إن وقع الأوّل منها في تفسير الكوّاشي و غيره من المعتمدين.
و من أعجبه ما اشتهر في قوله تعالى: وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [ (3) آل عمران:
102] فقد لهج العوامّ بأنّ معناه: متزوّجون، و هذا قول لا يعرف له أصلا و لا يجوز الإقدام على تفسير كلام اللّه بمجرّد ما يحدس في النّفس أو يسمع ممّن لا عهدة عليه.
النّوع الثالث و التّسعون: معرفة المفسّرين
هذا النّوع من زيادتي و هو مهمّ، و قد ألّف النّاس فيهم طبقات، فممّن اشتهر بمعرفة التّفسير من الصّحابة رضي اللّه عنهم: الخلفاء الأربعة، و عبد اللّه بن مسعود، فقد روى ابن جرير عنه أنّه قال: و الّذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب اللّه إلّا و أنا أعلم فيمن نزلت و أين نزلت و لو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب اللّه منّي تناله المطايا لأتيته.
و منهم: عبد اللّه بن عبّاس البحر ترجمان القرآن، فقد دعا له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فقال:
«اللّهم فقّهه في الدّين و علّمه التّأويل»، و قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عبّاس و من التّابعين: مجاهد بن جبر، فقد قرأ القرآن على ابن عبّاس ثلاث مرّات يسأله في كلّ مرّة عن تفسير آية، و لهذا قال سفيان الثّوري: إذا جاءك التّفسير عن مجاهد فحسبك به.
و منهم: سعيد بن جبير، و عكرمة مولى ابن عباس، و عطاء بن أبي رباح و الحسن البصري، و مسروق بن الأجدع، و سعيد بن المسيّب، و أبو العالية و الرّبيع بن أنس، و قتادة، و الضّحّاك بن مزاحم، و خلق، ثمّ حمل التّفسير من كلّ خلف خلق و ألّفوا فيه من الكتب كمقاتل و السّدّي و وكيع و عبد الرّزّاق و محمد بن يوسف الفريابي و أبي جعفر بن جرير و هو أجلّهم.
هذا النّوع من زيادتي، و هو نوع من أنواع علوم الحديث، و فيه مسائل:
الأولى: تستحبّ كتابة المصحف و تحسين كتابته و تبيينها و إيضاحها، و تحقيق الخطّ دون مشقّة و تعليقه، فقد روى أبو عبيد في فضائله عن عمر أنّه وجد مع رجل مصحفا قد
ص: 133
كتب بقلم دقيق فكره ذلك و ضربه و قال: عظّموا كتاب اللّه و كان عمر إذا رأى مصحفا عظيما سرّ به، و روي عن علي أنّه كره أن يكتب في شي ء صغير و أنّه مرّ على رجل يكتب فقال له: أجلل قلمك و نوّره كما نوّره اللّه.
و روي عن ابن سيرين أنّه كره كتابته مشقا، و تحرم كتابته بنجس، و أمّا بالذهب فهو حسن كما قال الغزالي، و روى أبو عبيد عن ابن مسعود أنه مرّ عليه بمصحف زيّن بالذّهب فقال: إنّ أحسن ما زيّن به المصحف تلاوته بالحقّ، و روي عن ابن عبّاس و أبي ذرّ و أبي الدّرداء أنّهم كرهوا ذلك، و عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ، و ذكر أصحابنا أنّه تكره كتابته على الحيطان و الجدران و على السّقوف أشدّ كراهة لأنّه يوطأ.
الثّانية: اختلف في نقط المصحف و شكله و يقال: أوّل من فعل ذلك: أبو الأسود الدّؤليّ بأمر عبد الملك بن مروان، و قيل: الحسن البصريّ، و يحيى بن يعمر، و قيل:
نصر ابن عاصم اللّيثي.
و أوّل من وضع الهمز و التّشديد و الرّوم و الإشمام: الخليل.
و قال قتادة: بدءوا فنقّطوا ثمّ خمّسوا ثمّ عشّروا، و قال غيره: أوّل ما أحدثوا النّقط عند آخر الآي ثمّ الفواتح و الخواتم.
و قال يحيى بن أبي كثير: ما كانوا يعرفون شيئا ممّا أحدث في المصاحف إلّا النّقط الثّلاث على رءوس الآي.
و قد روى أبو عبيد عن ابن مسعود أنّه قال: جرّدوا القرآن، و لا تخلطوه بشي ء، و روي عن إبراهيم: أنّه كره نقط المصاحف، و عن ابن سيرين: أنّه كره النّقط و الفواتح و الخواتم، و عن ابن مسعود و مجاهد: أنّهما كرها التّعشير، و قال مالك: لا بأس به في المصاحف الّتي يتعلّم فيها الغلمان، أمّا الأمّهات فلا.
و قال النّوويّ: نقط المصحف و شكله مستحبّ لأنّه صيانة له من اللّحن و التّحريف.
و قال البيهقيّ في الشّعب: من آداب القرآن أن يفخّم فيكتب مفرّجا بأحسن خط، و لا يصغّر، و لا تقرمط حروفه، و لا يخلط به ما ليس منه كعدد الآيات و السّجدات و العشرات و الوقوف و اختلاف القراءات و معاني الآيات.
و قال ابن مجاهد: ينبغي ألّا يشكل إلّا ما يشكل.
ص: 134
و قال الدّاني: لا أستجيز النّقط بالسّواد لما فيه من التّغيير لصورة الرّسم، و لا أستجيز جمع قراءات شتّى في مصحف واحد بألوان مختلفة لأنّه من أعظم التّخليط و التّغيير للمرسوم، و أرى أن تكون الحركات و التّنوين و التّشديد و السّكون و المدّ بالحمرة و الهمزات بالصّفرة، انتهى.
الثّالثة: فهي رسم المصحف و فيه تصانيف كثيرة أشهرها: المقنع للدّاني و الرّائيّة للشّاطبي و هو متّبع لا يراعى فيه القواعد النّحويّة و قد حرّرته على ترتيب لم أسبق إليه و ضبطته بقواعد بعد أن يعرف أنّ الأصل في كلّ كلمة أن ترسم بحروف هجائها، القاعدة الأولى: في الحذف، تحذف الألف من ياء النّداء نحو يا أيّها النّاس، يآدم، يربّ.
و هاء التّنبيه نحو: هؤلاء، هأنتم، و نا مع ضمير نحو: أنجينكم، آتينه، و من ذلك:
أولئك، و لكنّ، و و تبرك. و فروع الأربعة: و «اللّه»، و «إله» كيف وقع، و «الرحمن»، و «سبحن» كيف وقع إلّا: قُلْ سُبْحانَ رَبِّي [ (17) الإسراء: 93] و بعد لام نحو: «خلئف» خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ [ (9) التوبة: 81] «غلم»، «إيلف»، «ملقوا»- و بين لامين نحو: «الكللة» و «الضّللة»، خلل الدّيار، لَلَّذِي بِبَكَّةَ [ (3) آل عمران: 96] و من كلّ علم زائد على ثلاثة:
كإبراهيم و صلح، و ميكئيل، و اللّت، إلّا جالوت و طالوت و يأجوج و مأجوج و داود لحذف واوه و إسرايل لحذف يائه. و اختلف في هاروت و ماروت و هامان و قارون، و من كلّ مثنّى اسم أو فعل إن لم يتطرف نحو: «رجلن يعلّمن»، أضلنا، إِنْ هذانِ [ (20) طه: 63] إلّا بِما قَدَّمَتْ يَداكَ [ (22) الحج: 10] و من كلّ جمع تصحيح لمذكّر أو مؤنّث نحو:
اللّعنون، ملقوا ربّهم إلّا: «طاغون» في الذّاريات و الطور [سورة الذاريات: 53، و الطور: 23]. و «كراما كاتبين»، و إلّا: «روضات» و «آيات للسّائلين»، و «مكر في ءآياتنا»، «ءآياتنا بيّنات» «في يونس» [سورة يونس: 15]. و إلّا إن تلاها همزة نحو: «الصّائمين و الصّائمات»، أو تشديد نحو: «الضالّين» و «الصّافّات»، فإن كان في الكلمة ألف ثانية حذفت أيضا إلّا: سَبْعَ سَماواتٍ [ (41) في فصلت: 12] و من كلّ جمع على «مفاعل» أو شبهه نحو: المسجد [و مسكن و اليتمى و النّصرى و المسكين و الملائكة و الخبئث].
و الثانية: من: (خطينا) كيف وقع، و من كلّ عدد كثلث و ثلث، و سحر إلّا في آخر الذّاريات. فإن ثنّي فألفاه و القيمة، و الشّيطن، و سلطن، و اللّتي، و اللّئي، و خلق، علم، و بقدر، و الأصحب، و الأنهر، و الكتب، و منكر الثّلاثة إلّا أربعة مواضع لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ [ (13) الرعد: 38]، كِتابٌ مَعْلُومٌ [ (15) الحجر: 4]، كِتابِ رَبِّكَ [ (18) الكهف: 27] و كِتابٍ مُبِينٍ في النمل [النمل: 1] و من البسملة، و بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها و من أوّل الأمر من سأل.
ص: 135
و من كلّ ما اجتمع فيه ألفان أو ثلاثة نحو: آدَمَ (آخر) أَ أَشْفَقْتُمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ و من: رآ كيف وقع إلّا: ما رَأى و لَقَدْ رَأى في النّجم [النجم:
11، 18] و آلئن إلّا: فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ [ (82) الجن: 9]. و الألفان من: الْأَيْكَةِ إلّا في الحجر [الحجر: 78]. و ق [ق: 14]. و تحذف الياء من كلّ منقوص منوّن رفعا و جرّا نحو باغٍ وَ لا عادٍ و المضاف لها إذا نودي إلّا: يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا [ (29) العنكبوت: 56]، أو لم يناد إلّا وَ قُلْ لِعِبادِي [ (17) الإسراء: 53]. أَسْرِ بِعِبادِي [طه: 77، الدخان 23]، في طه و الدخان فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي [ (89) الفجر: 29، 30] و مع مثلها نحو:
وَلِيِّيَ و الْحَوارِيِّينَ و مُتَّكِئِينَ إلّا عِلِّيِّينَ و يُهَيِّئْ و هَيِّئْ و مَكْرَ السَّيِّئِ و سَيِّئَةً و (السيئة) أ فعيينا و يُحْيِي مع ضمير لا مفردا و حيث وقع أَطِيعُونِ (اتقون) خافُونِ (ارهبون) فَأَرْسِلُونِ و (اعبدون) إلا في يس [ (36) يس: 61] و (اخشون) إلّا في البقرة [ (2) البقرة: 150]. و يَكِيدُونَ إلّا: فَكِيدُونِي جَمِيعاً [ (11) هود: 55]. و اتَّبِعُونِ إلّا في آل عمران [ (3) آل عمران: 31]. و طه [طه: 90]. و (لا تنظرون) و (لا تستعجلون)، و لا تَكْفُرُونِ، و لا تَقْرَبُونِ، و لا تُخْزُونِ، و (لا تفضحون)، يَهْدِيَنِ و سَيَهْدِينِ و (كذبون) و يَقْتُلُونَ، أَنْ يُكَذِّبُونِ و وَعِيدِ و الْجَوارِ و بِالْوادِ و الْمُهْتَدِ إلّا في الأعراف و تحذف الواو مع أخرى نحو: لا يَسْتَوُونَ، فاؤُ و إِذَا الْمَوْؤُدَةُ، يؤسا، و تحذف اللّام مدغمة في مثلها نحو: الّيل، الّذي، إلّا اللّه، اللّهمّ، اللّعنة و فروعه و اللّهو، و اللّغو، و اللّؤلؤ، و اللات، و اللّمم، و اللّهب، و اللّطيف، و اللّوّامة.
ص: 136
حذفت الألف من: (ملك الملك) [ (3) آل عمران: 26]، (ذرّيّة ضعفا) [ (4) النساء: 9] (مرغما) [ (4) النساء: 100]. (خدعهم) [ (4) النساء: 142]. (أكّالون للسّحت) [ (5) المائدة:
42]. (بلغ) [ (65) الطلاق: 2] (ليجادلوكم) [ (6) الأنعام: 121] في الأعراف وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ [ (7) الأعراف: 118]. و هود [هود: 16]. في الأنفال (الميعد) [ (6) الأنفال: 42]. تربا في الرّعد [الرعد: 5]. و النمل [النمل: 67]. و عمّ [الآية الأخيرة]. (جذذا) [ (21) الأنبياء:
58]. يُسارِعُونَ [ (5) المائدة: 52]، (أيّه المؤمنون) [ (24) النور: 31]. (يأيّه السّاحر) [ (44) الدخان: 49]. أَيُّهَ الثَّقَلانِ [ (55) الرحمن: 31]. (أمّ موسى فرغا) [ (28) القصص: 10] (و هل نجزي) [ (34) سبأ: 17]. (من هو كذب) [ (39) الزمر: 3] لِلْقاسِيَةِ [ (39) الزمر: 22] في الزمر (أثرة) [ (46) الأحقاف: 4]. (عهد عليه اللّه) [ (48) الفتح: 10] (و لا كذبا) [ (78) النبأ:
35]. و حذفت الياء من إِبْراهِيمَ في سورة البقرة [ (2) البقرة: 258]. و الدَّاعِ إِذا دَعانِ [ (2) البقرة: 186]. و مَنِ اتَّبَعَنِ [ (3) آل عمران: 20] و (فسوف يأت اللّه) [ (5) المائدة: 54]. و (قد هذن) [ (6) الأنعام: 80]. نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ [ (10 يونس: 103]. فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ [ (11) هود: 46]. يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ [ (11) هود: 105]. حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً [ (12) يوسف: 66].
تُفَنِّدُونِ [ (12) يوسف: 94]. الْمُتَعالِ [ (13) الرعد: 30]. مَآبٍ [ (13) الرعد: 29].
عِقابِ [ (13) الرعد: 32]. في الرّعد و غافر و ص أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ [ (14) إبراهيم: 22] وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ [ (14) إبراهيم: 40] لَئِنْ أَخَّرْتَنِ [ (17) الإسراء: 62]. أَنْ يَهْدِيَنِ [ (18) الكهف: 24]. إِنْ تَرَنِ [ (18) الكهف: 39]. أَنْ يُؤْتِيَنِ [ (18) الكهف: 40] أَنْ تُعَلِّمَنِ [ (18) الكهف: 66] و نَبْغِ [ (18) الكهف: 64] الخمسة في الكهف أَلَّا تَتَّبِعَنِ في طه [ (20) طه: 93] وَ الْبادِ [ (22) الحج: 25] وَ إِنَّ اللَّهَ لَهادِ [ (22) الحج: 54] أَنْ يَحْضُرُونِ [ (23) المؤمنون: 98] رَبِّ ارْجِعُونِ [ (23) المؤمنون: 99] وَ لا تُكَلِّمُونِ [ (23) المؤمنون: 108] يَسْقِينِ [ (26) الشعراء: 81] يَشْفِينِ [ (26) الشعراء: 80] يُحْيِينِ [ (26) الشعراء: 81] وادِ النَّمْلِ [ (27) النمل: 18] أَ تُمِدُّونَنِ [ (27) النمل: 36] (فما آتان) [ (27) النمل: 36] تَشْهَدُونِ [ (27) النمل: 32] (بهدي العمي) [ (27) النمل: 81] كَالْجَوابِ [ (34) سبأ: 13] إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ [ (36) يس: 23] لا يُنْقِذُونِ [ (36) يس: 23] فَاسْمَعُونِ [ (36) يس:
ص: 137
23] لَتُرْدِينِ [ (37) الصافات: 56] صالِ الْجَحِيمِ [ (37) الصافات: 163] التَّلاقِ [ (40) غافر: 15] التَّنادِ [ (40) غافر: 32] تَرْجُمُونِ [ (44) الدخان: 20] فَاعْتَزِلُونِ [ (44) الدخان:
21] يُنادِ الْمُنادِ [ (50) ق: 41] لِيَعْبُدُونِ [ (51) الذاريات: 56] يُطْعِمُونِ [ (51) الذاريات:
57] يَدْعُ الدَّاعِ مرتين في القمر [ (54) القمر: 6، 8] وَ يَسِّرْ [ (89) الفجر: 4] أَكْرَمَنِ [ (89) الفجر: 15] (أهنن) [ (89) الفجر: 16] وَ لِيَ دِينِ [ (109) الكافرون: 6] و حذفت الواو من: وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ [ (17) الإسراء: 11] في حم وَ يَمْحُ اللَّهُ [ (42) الشورى: 24] يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ [ (54) القمر: 6] سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ [ (96) العلق: 18].
زيدت ألف بعد الواو آخر اسم مجموع نحو: بَنُوا إِسْرائِيلَ [ (10) يونس: 90] (ملقوا ربّهم) [ (2) البقرة: 46] أُولُوا الْأَلْبابِ [ (3) آل عمران: 7] بخلاف المفرد نحو: لَذُو عِلْمٍ [ (12) يوسف: 68] إلّا الرِّبَوا [ (2) البقرة: 278] (إن امرؤا هلك) [ (4) النساء: 176].
و آخر فعل مفرد أو جمع مرفوع أو منصوب إلّا: جاؤُ و باؤُ حيث وقعا و (عتو عتوّا) [ (25) الفرقان: 21] فَإِنْ فاؤُ [ (2) البقرة: 226] (و الّذين تبوّؤ الدّار) [ (59) الحشر: 9] في النساء عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ [ (4) النساء: 99] (سعو في آياتنا) في سبأ [ (34) سبأ: 5].
و بعد الهمزة المرسومة واوا نحو: تَفْتَؤُا و في مِائَةَ و مِائَتَيْنِ و الظُّنُونَا و الرَّسُولَا و السَّبِيلَا وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ [ (18) الكهف: 23] أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ [ (27) النمل:
21] (و لأاوضعوا) [ (9) التوبة: 47] و (لا إلى الله) [ (3) آل عمران: 158] و (لا إلى الجحيم) [ (37) الصافات: 68] و (لا تايئسوا) و (إنّه لا يايئس) [ (12) يوسف: 87] (أ فلم يايئس) [ (13) الرعد: 31].
و بين الياء و الجيم في (جاى) [ (39) الزمر: 69] في الزمر و زيدت ياء في (نبإى المرسلين) [ (6) الأنعام: 34] و (ملايه) [ (10) يونس: 75] و (ملإيهم) [ (10) يونس: 83] (و من آناء اللّيل) في طه [ (20) طه: 130] (و من تلقائي نفسي) [ (10) يونس: 15] (من وراءي حجاب) في الشورى [ (42) الشورى: 51] في النّحل (و إيتائ ذي القربى) [ (16) النحل: 90] (و لقاءي الآخرة) في الرّوم [ (30) الروم: 26] (بأييكم المفتون) [ (68) القلم: 6] (بنيناها بأييد) [ (51) الذاريات: 47] (أ فإين متّ) [ (21) الأنبياء: 43] و زيدت واو في: ألوا و فروعه (سأوريكم) [ (7) الأعراف: 145] و كتب ابن الهمزة مطلقا.
ص: 138
يكتب السّاكن بحرف حركة ما قبله أوّلا أو وسطا أو آخرا نحو: ائْذَنْ اؤْتُمِنَ و الْبَأْساءِ اقْرَأْ جِئْناكَ هَيِّئْ الْمُؤْتُونَ (تسوؤهم) إلّا: (فادّارأتم) [ (2) البقرة: 72] (رءيا) [ (19) مريم: 74] (الرّءيا) [ (17) الإسراء: 60] (شطئه) [ (48) الفتح: 29] فحذف فيها.
و كذا أوّل الأمر بعد فاء نحو: فَأْتُوا أو واو نحو: وَ أْتَمِرُوا و المتحرّك: إن كان أوّلا أو اتّصل به حرف زائد بالألف مطلقا نحو: أَيُّوبَ إِذْ أولوا سَأَصْرِفُ فَبِأَيِّ سَأُنْزِلُ إلّا مواضع: أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ [ (6) الأنعام: 19] (أ انّا لتأتون) في النّمل و العنكبوت [النمل: 55] أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ [فصّلت: 9] أَ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ في النّمل [ (27) النمل: 67] أَ إِنَّا لَتارِكُوا [ (41) الصافات: 36] في الشعراء أَ إِنَّ لَنا في الشعراء [ (26) الشعراء: 41] أَ إِذا مِتْنا [ (41) الصافات: 86] أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ [ (36) يس: 19] أَ إِفْكاً [ (41) الصافات: 86] أَئِمَّةً [ (32) السجدة: 24] لِئَلَّا [ (4) النساء: 165] لَئِنْ [ (39) الزمر: 65] يَوْمَئِذٍ [ (89) الفجر: 23] حِينَئِذٍ فتكتب فيها بالياء إلّا (قل أ ؤنبّئكم) [ (3) آل عمران: 15] و هؤُلاءِ فتكتب بالواو و إن كان وسطا فبحرف حركته نحو سَأَلَ سُئِلَ نَقْرَؤُهُ إلّا جَزاؤُهُ الثلاثة في يوسف [يوسف: 74، 65،] و لَأَمْلَأَنَّ و (امتلأت) و (اشمئزّت) وَ اطْمَأَنُّوا فحذف فيها و إلّا أن فتح و كسر أو ضمّ ما قبله، أو ضمّ و كسر ما قبله فبحرفه نحو (الخاطئة) فُؤادَكَ سَنُقْرِئُكَ فإن كان ما قبله ساكنا حذف هو نحو: يُسْئَلُ (لا تجرءوا) إلّا: النَّشْأَةَ [ (56) الواقعة: 62] و مَوْئِلًا [ (18) الكهف: 58] في الكهف، فإن كان ألفا و هو مفتوح فقد سبق أنّها تحذف لاجتماعها مع ألف مثلها إذ الهمزة حينئذ بصورتها نحو: أَبْناءَنا و حذف منها أيضا في: (قرءنا) في يوسف [ (12) يوسف: 2] و الزخرف [الزخرف: 3] فإن ضمّ أو كسر فلا نحو: آباؤُكُمْ آبائِهِمْ إلا: وَ قالَ أَوْلِياؤُهُمْ [ (6) الأنعام: 128] إِلى أَوْلِيائِهِمْ [ (6) الأنعام: 121] في الأنعام إِنْ أَوْلِياؤُهُ في الأنفال [ (8) الأنفال: 34] في فصّلت نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ [ (41) فصلت: 31] و إن كان بعده حرف يجانسه فقد سبق أيضا أنه يحذف نحو: (شنئان) [ (5) المائدة: 8] خاسِئِينَ [ (2) البقرة: 65] مُسْتَهْزِؤُنَ [ (2) البقرة: 14] و إن كان آخرا فبحرف حركة ما قبله نحو: (سبأ) شاطِئِ لُؤْلُؤٌ إلّا في مواضع: (تفتؤا) يَتَفَيَّؤُا أَتَوَكَّؤُا لا تَظْمَؤُا ما يَعْبَؤُا يَبْدَؤُا يُنَشَّؤُا يَدْرَؤُا (نبؤا) (فقال الملأ) الأوّل في قد أفلح [المؤمنون: 24] و الثّلاثة في النمل [النمل: 29، 32، 38] (جزاؤ) في خمسة مواضع اثنان في المائدة [المائدة: 29، 33] و في الزمر [الزمر: 34] الشورى [الشورى: 40] و الحشر [الحشر: 6] في الأنعام (شركؤا) [ (6) الأنعام: 22]
ص: 139
و شورى [الشورى: 21] (يأتيهم أنبؤا) في الأنعام [ (6) الأنعام: 5] وَ الشُّعَراءُ [ (26) الشعراء: 6] (علمؤا بني) [ (26) الشعراء: 197] (من عباده العلمؤا) [ (35) فاطر: 28] في إبراهيم (الضّعفؤا) في إبراهيم [ (14) إبراهيم: 20] و غافر [ (40) غافر: 47] (في أموالنا ما نشؤا) و (ما دعؤا) [ (40) غافر: 50] في غافر (شفعؤا) في الرّوم [ (30) الروم: 13] (إنّ هذا لهو البلؤا) [ (37) الصافات: 106] (بلؤا مبين) في الدخان [ (44) الدخان: 13] (برآؤا منكم) [ (60) الممتحنة: 4] فكتب في الكلّ بالواو فإن سكن ما قبله حذف هو نحو: مِلْ ءُ الْأَرْضِ دِفْ ءٌ شَيْ ءٍ الْخَبْ ءَ (ماء) إلا لَتَنُوأُ و (أن تبوّءا) و (السّوأى) كذا قاله الفرّاء و الّذي عندي أنّ هذه الثّلاثة لا تستثنى لأنّ الألف الّتي بعد الواو ليست صورة الهمزة بل هي المزيدة بعد واو الفعل فتأمّل.
يكتب بالواو ألف الصّلوة و الزّكوة، و الحيوة و الرّبوا غير مضافات. و (الغداة)، و (مشكاة)، و (النّجوة)، و (مناة) و بالياء كلّ ألف منقلبة عنها نحو: يَتَوَفَّاكُمْ في اسم أو فعل اتّصل به ضمير أو لا، لقي ساكنا أم لا. و منه: يا وَيْلَتى يا حَسْرَتى يا أَسَفى إلّا تَتْرا و كِلْتَا وَ مَنْ عَصانِي (و الأقصا) و أَقْصَا الْمَدِينَةِ و مَنْ تَوَلَّاهُ و (طغا الماء) و (سيماهم) و ما قبلها ياء كالدّنيا، و الحوايا، و هدايا، إلّا يحيى اسما و فعلا و يكتب بها: على، و إلى و أنّى بمعنى كيف، و متى، و بلى، و حتى، ولدى إلا: (لدا الباب) و يكتب بالألف الثّلاثيّ الواويّ اسما أو فعلا نحو:
الصَّفا، (و شفا)، (و عفا). إلّا: ضحى كيف وقع، و ما زَكى مِنْكُمْ و دَحاها و تَلاها و طَحاها، و سَجى و يكتب بالألف نون التّأكيد الخفيفة، وَ إِذْ، و بالنون:
كَأَيِّنْ و بالهاء هاء التأنيث إلّا: رَحْمَتَ في البقرة، و الأعراف، و هود، و مريم، و الرّوم، و الزّخرف [البقرة، و الأعراف، هود، مريم، الروم، الزخرف: 218، 56، 73، 2، 50، 32].
و (نعمت) في البقرة و آل عمران و المائدة و إبراهيم و النّحل و لقمان و فاطر و الطور [البقرة، آل عمران، المائدة، إبراهيم، النحل، و لقمان، و فاطر، و الطور: 231، 103، 11، 28، 34، 72، 83، 114، 31، 3].
و سُنَّتُ في الأنفال و فاطر و غافر [الأنفال، فاطر، و غافر: 38، 43، 85] و امْرَأَتُ مع زوجها [آل عمران: 35] وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى [ (7) الأعراف: 137] فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ [ (3) آل عمران: 61] و الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ [ (24) النور: 7] و (معصيت) في المجادلة [في موضعين: 8، 9] (إنّ شجرت الزّقّوم) [ (44) الدخان: 43] قُرَّتُ عَيْنٍ [ (28) القصص: 9] و (جنات نعيم) [ (56) الواقعة: 89] و بَقِيَّتُ اللَّهِ [ (11) هود: 86] يا أَبَتِ [ (12) يوسف: 4]
ص: 140
و اللَّاتَ [ (38) ص: 3] و مَرْضاتِ [ (2) البقرة: 265] و هَيْهاتَ [ (23) المؤمنون: 36] و ذاتَ [ (27) النمل: 60] و ابْنَتَ [ (66) التحريم: 12] و فِطْرَتَ [ (30) الروم: 30].
توصل ألّا بالفتح إلّا عشرة مواضع: أَنْ لا أَقُولَ (أن لا تقولوا) [ (7) الأعراف: 105]؛ في الأعراف [ (7) الأعراف: 105، 169] أَنْ لا مَلْجَأَ في التوبة [ (9) التوبة: 118] أَنْ لا إِلهَ [ (11) هود: 14] أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخافُ [ (11) هود: 26] أَنْ لا تُشْرِكْ في الحج [ (22) الحج: 26] أَنْ لا تَعْبُدُوا [ (36) يس: 60] في يس وَ أَنْ لا تَعْلُوا في الدّخان [ (33) الدخان: 19] أَنْ لا يُشْرِكْنَ الممتحنة [ (60) الممتحنة: 12] أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا في ن [ (68) ن: 24] و (مما): إلّا: (من ما ملكت) في النّساء و الرّوم [النساء و الروم: 25، 28] مِنْ ما رَزَقْناكُمْ في المنافقين [ (63) المنافقون: 10] و (ممن) مطلقا و (عما) إلّا: عَنْ ما نُهُوا [ (7) الأعراف: 166] و (إما) بالكسر إلا:
و إِنْ ما نُرِيَنَّكَ في الرّعد [ (13) الرعد: 40] و (أما) بالفتح مطلقا و (عمّن) إلّا:
و يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ [ (24) النور: 43] في النور عَنْ مَنْ تَوَلَّى في النجم [ (53) النجم:
29] و (أمن) إلّا: أَمْ مَنْ يَكُونُ في النساء [ (4) النساء: 109] أَمْ مَنْ أَسَّسَ [ (9) التوبة:
109] أَمْ مَنْ خَلَقْنا في الصّافّات [ (37) الصافات: 11] أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً [ (41) فصلت: 40] و الم بالكسر إلّا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا [ (28) القصص: 50] و فِيما إلّا: أحد عشر:
فِي ما فَعَلْنَ الثّاني في البقرة [البقرة: 240] لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما في المائدة و الأنعام [المائدة، و الأنعام: 48، 165] قُلْ لا أَجِدُ فِي ما [ (6) الأنعام: 145] فِي مَا اشْتَهَتْ في الأنبياء [ (21) الأنبياء: 102] (في ما أفضتم) [ (24) النور: 14] فِي ما هاهُنا في الشعراء [ (26) الشعراء: 146] فِي ما رَزَقْناكُمْ في الرّوم [ (30) الروم: 28] فِي ما هُمْ فِيهِ فِي ما كانُوا فِيهِ كلاهما في الزّمر [ (39) الزمر: 3، 46] وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ [ (56) الواقعة: 61] (و نعمّا) و (مهما) و رُبَما و (كأنما) وَ إِنَّما إلا: إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ في الأنعام [ (6) الأنعام: 134] و أنّما بالفتح إلّا: وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ في الحجّ و لقمان [الحج: 61، و لقمان: 30] و (كلما) إلّا: (كلّ ما ردّوا إلى الفتنة) [ (4) النساء: 91] مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ [ (14) إبراهيم:] و (بئسما) إلّا مع اللّام و وَيْكَأَنَّ و تقطع حَيْثُ ما [ (2) البقرة: 144] و (أن لم) بالفتح [الأنعام: 131، البلد: 7] و (أن لن) إلّا في الكهف و القيامة [الكهف: 48، و القيامة:
3] و (أين ما) إلّا: فَأَيْنَما تُوَلُّوا [ (2) البقرة: 115] أَيْنَما يُوَجِّهْهُ [ (16) النحل: 76]، و اختلف في: (أين ما تكونوا يدرككم الموت) [ (4) النساء: 78] في الشعراء (أينما كنتم تعبدون) [ (26) الشعراء: 92] في الأحزاب أَيْنَما ثُقِفُوا [ (33) الأحزاب: 61] و لِكَيْ لا إلّا
ص: 141
في آل عمران و الحج و الحديد و الثاني في الأحزاب [آل عمران: 153، و الحج: 5، و الحديد: 23، و الأحزاب: 50] و (يوهم هم) [ (40) غافر: 16 (61) الذاريات: 13]، و نحو: (فمال) [ (70) المعارج:
36] و لاتَ حِينَ [ (38) ص: 3] و ابْنَ أُمَّ إلّا في طه فكتبت الهمزة حينئذ واوا، و حذفت همزة (ابن) فصارت هكذا: يبنؤمّ [ (20) طه: 94].
في ما فيه قراءتان فكتب على أحدهما، و مرادنا: القراءات المشهورة فمن ذلك: (ملك يوم الدّين) (يخدعون) [ (2) البقرة: 9] (و وعدنا) [ (2) البقرة:
51] و (الصعقة) [ (51) الذاريات: 44] و (الرّيح) [ (2) البقرة: 164] و تُفادُوهُمْ [ (2) البقرة: 85] و تُظْهِرُونَ [ (2) البقرة: 85] و (لا تقتلوهم) [ (2) البقرة: 191] (نحوها) و لَوْ لا دَفْعُ [ (2) البقرة: 251] (فرهن) [ (2) البقرة: 283] طَيْراً [ (3) آل عمران: 49] في: المائدة و آل عمران فَيُضاعِفَهُ [ (2) البقرة: 245]، و نحو: عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ [ (4) النساء: 33] الْأَوَّلِينَ [ (5) المائدة: 107] (لمستم) [ (4) النساء: 43] قاسِيَةً [ (5) المائدة: 13] قِياماً لِلنَّاسِ [ (5) المائدة:
97] خَطِيئاتِكُمْ في الأعراف [ (7) الأعراف: 161] طائِفٌ [ (7) الأعراف: 201] حاشَ لِلَّهِ [ (12) يوسف: 31] (و سيعلم الكفر) [ (13) الرعد: 42] (تزور) [ (18) الكهف: 17] زَكِيَّةً [ (18) الكهف: 74] فَلا تُصاحِبْنِي [ (18) الكهف: 76] لَاتَّخَذْتَ [ (18) الكهف: 77] مِهاداً [ (20) طه: 53] وَ حَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ [ (21) الأنبياء: 95] إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ [ (22) الحج: 38] سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى [ (22) الحج: 2] الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ [ (23) المؤمنون:
14] سِراجاً [ (25) الفرقان: 61] بَلِ ادَّارَكَ [ (27) النمل: 66] وَ لا تُصَعِّرْ [ (31) لقمان: 18] رَبَّنا باعِدْ [ (34) سبأ: 29] أَسْوِرَةٌ [ (43) الزخرف: 53]، بلا ألف في الكلّ. غَيابَتِ الْجُبِّ [ (12) يوسف: 10]، في العنكبوت لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ [ (29) العنكبوت: 50] في فصّلت مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها [ (41) فصلت: 47] جِمالَتٌ [ (77) المرسلات: 33] (فهم على بينات) [ (35) فاطر: 4] وَ هُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ [ (34) سبأ: 37] لِأَهَبَ [ (19) مريم:
19] بالألف يَقُصُّ الْحَقَّ [ (6) الأنعام: 57] بلا ياء، آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ [ (18) الكهف:
96] بألف فقط فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ [ (12) يوسف: 67] (نجي المؤمنين) [ (21) الأنبياء: 88] بنون واحدة و الصِّراطَ [ (1) الفاتحة: 5] كيف وقع بَصْطَةً في الأعراف [ (7) الأعراف:
69]، و الْمُصَيْطِرُونَ [ (52) الطور: 37] و (مصيطر) [ (88) الغاشية: 22] بالصاد، و قد تكتب الكلمة صالحة للقراءتين نحو: فَكِهِينَ بلا ألف و هي قراءة [المطففين: 31]، و على قراءتها هي محذوفة رسما لأنّه جمع تصحيح.
ص: 142
و أمّا القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرّسم و نحوها نحو:
(أوصى و وصى) [البقرة: 132] و (و تجري تحتها) و (من تحتها) [التوبة: 100] و (سيقولون اللّه و للّه) و (ما عملت أيديهم، و ما عملته) [يس: 35] فكتابته على نحو قراءته و كلّ ذلك وجد في مصاحف الإمام فهذا ما حرّرته من كتب الرّسم على انتشارها بعد تعب شديد فضبطته بهذه القواعد الّتي لم أسبق إلى تحريرها و لا يخرج عنها إن شاء اللّه إلّا ما اختلف فيه.
كان الشّكل في الصّدر الأوّل نقطا، فالفتحة نقطة على أوّل الحرف، و الضّمّة على آخره، و الكسرة تحت أوّله، و عليه مشى الدّاني و السّدّي و الّذي اشتهر الآن الضّبط بالحركات المأخوذة من الحروف و هو الّذي أخرجه الخليل و هو أكثر و أوضح و عليه العمل فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف و الكسر كذلك تحته، و الضّمّ واو صغرى فوقه، و التّنوين زيادة مثلها فإن كان مظهرا و ذلك قبل حرف حلق ركّبت فوقها و إلّا تابعت بينهما.
و تكتب الألف المحذوفة و المبدل منها في محلّها حمراء، و الهمزة المحذوفة تكتب همزة بلا حرف حمراء أيضا، و على النّون و التّنوين قبل الباء علامة الإقلاب (م) حمراء، و قبل الحلق سكون و تعرّى عند الإدغام و الإخفاء، و يسكّن كلّ مسكّن، و يعرى المدغم، و يشدّد ما بعده إلّا الطّاء قبل التّاء فيكتب عليها السّكون نحو: فَرَّطْتُ [ (42) الشورى: 55] و مطّة الممدود لا تجاوزه.
ص: 143
هذا النّوع من زيادتي، و فيه مسائل:
الأولى: اختلف هل يجوز أن يقال: سورة البقرة، و سورة آل عمران، و سورة النّساء، و سورة المائدة و نحو ذلك.
و الجمهور على جوازه ففي الصّحيح عن ابن مسعود أنّه قال: هذا مقام الّذي أنزلت عليه سورة البقرة، و في مسند أحمد أن العبّاس نادى بأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم لمّا فرّ الصّحابة يوم حنين: يا أصحاب الشّجرة، يا أصحاب البقرة، فجعلوا يقبلون.
و قال جماعة: لا يقال ذلك، بل السّورة الّتي يذكر فيها كذا.
ففي الطّبرانيّ عن أنس مرفوعا: «لا تقولوا سورة البقرة، و لا سورة آل عمران و لا سورة النّساء، و كذلك القرآن كلّه، و لكن قولوا: السّورة الّتي يذكر فيها البقرة و التي يذكر فيها آل عمران و كذا القرآن كلّه»، و هذا حديث ضعيف غريب. و قال ابن كثير: لا يصحّ رفعه، و قال البيهقيّ: إنّما يعرف موقوفا على ابن عمر.
الثّانية: قد سبق في حدّ السّورة أنّها المسمّاة توقيفا، فظاهره أنّه لا يجوز إلّا بتوقيف من النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، و المراد: الاسم الّذي تذكر به و تشتهر، و إلّا فقد سمّى جماعة من الصّحابة و التّابعين سورا بأسماء من عندهم، كما سمّى حذيفة التّوبة بالفاضحة و سورة العذاب و سمّى خالد بن معدان البقرة: فسطاط القرآن، و سمّى سفيان بن عيينة الفاتحة: الوافية، و سمّاها يحيى بن أبي كثير: الكافية، لأنّها تكفي عمّا عداها.
الثّالثة: من السّور ما كان له اسمان فأكثر- فالفاتحة تسمّى: أمّ القرآن و أم الكتاب، و سورة الحمد، و سورة الصّلاة، و الشّفاء، و السّبع المثاني، و الرّقية و النّور، و الدّعاء، و المناجاة، و الشّافية، و الكافية، و الكنز، و الأساس، و براءة تسمّى: التّوبة، و الفاضحة، و سورة العذاب، و يونس تسمّى: السّابعة لأنّها سابعة السّبع الطّوال. و الإسراء تسمّى: سورة بني إسرائيل. و السّجدة تسمّى: المضاجع. و فاطر تسمّى: سورة الملائكة. و غافر تسمّى:
المؤمن. و فصّلت تسمّى: السّجدة. و الجاثية تسمّى: الشّريعة، و سورة محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم تسمّى:
القتال. و الطّلاق تسمّى: سورة النّساء القصرى.
و قد يوضع اسم لجملة من السّور: كالزّهراوين للبقرة و آل عمران، و السّبع الطّوال و هي: البقرة و ما بعدها إلى الأعراف، و السّابعة: يونس، كذا روي عن سعيد بن جبير و مجاهد.
ص: 144
و المفصّل: و الأصحّ أنّه من الحجرات إلى آخر القرآن لكثرة الفصل بين سورة بالبسملة، و المعوّذات: للإخلاص و الفلق و النّاس.
هذا النّوع من زيادتي، اختلف هل ترتيب الآي و السّور على النّظم الّذي هو الآن عليه بتوقيف من النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، أو باجتهاد من الصّحابة؟ فذهب قوم إلى الثّاني تمسّكا بحديث سؤال ابن عبّاس الآتي.
و بما روي عن عليّ أنّه كان عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله و أنّ أوّل مصحفه كان: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ و كذا مصحف أبيّ و ابن مسعود فيه اختلاف شديد في التّرتيب، و اختار مكّيّ و غيره أنّ ترتيب الآيات و البسملة في الأوائل من النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و ترتيب السّور باجتهاد الصّحابة.
و المختار أنّ الكلّ من النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم.
فقال الكرمانيّ في البرهان بعد أن ذكر الحكمة في قوله تعالى في البقرة: يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ [ (2) البقرة: 21] و ليس في القرآن غيره، إنّ العبادة المراد بها التّوحيد، و هو أوّل ما يلزم العبد، فكان هذا أوّل خطاب خاطب اللّه به النّاس في القرآن فخاطبهم أوّلا بما ألزمهم، ثمّ ذكر سائر العبادات فما بعدها من السّور و الآيات.
فإن قيل: ليست سورة البقرة بأوّل القرآن نزولا فيحسن فيها ما ذكرت.
قلت: أوّل القرآن: الفاتحة ثمّ البقرة ثمّ آل عمران على التّرتيب إلى سورة النّاس، و هكذا هو عند اللّه في اللّوح المحفوظ على هذا التّرتيب و كان صلّى اللّه عليه و سلّم يعرض على جبريل كلّ سنة ما كان يجتمع عنده منه، و عرضه في السّنة الّتي توفّي فيها مرّتين، و كان آخر الآيات نزولا: وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ [ (2) البقرة: 281] فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الرّبا و الدّين. انتهى.
و كذا قال الطّيبي: أنزل القرآن أوّلا جملة واحدة من اللّوح المحفوظ إلى السماء الدّنيا ثم نزل متفرقا على حسب المصالح ثم أثبت في المصاحف على التّأليف و النظم المثبت في اللّوح المحفوظ.
و قال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم مرتّبا سوره و آياته على هذا التّرتيب إلّا الأنفال و براءة.
ص: 145
لما روى الحاكم و غيره عن ابن عبّاس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال و هي من المثاني و إلى براءة و هي من المئين فقرنتم بينهما و لم تكتبوا بينهما سطر: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، و وضعتموها في السّبع الطّوال، فقال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يأتي عليه الزّمان و هو ينزل عليه من السّور ذوات العدد، و كان إذا نزل عليه الشّي ء دعا بعض من يكتب له فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات في السّورة الّتي فيها كذا و كذا».
و كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، و كانت براءة من آخر القرآن نزولا، و كانت قصّتها شبيهة بقصّتها فظننت أنّها منها فقبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، و لم يبيّن لنا أنّها منها، فمن ثم قرنت بينهما و لم أكتب بينهما سطر: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم.
و قال الحاكم: جمع القرآن ثلاث مرّات.
إحداها: بحضرة النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم ثمّ روي عن زيد بن ثابت قال: كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، نؤلّف القرآن من الرّقاع- الحديث- و قال: صحيح على شرط الشّيخين.
الثّانية: بحضرة أبي بكر، فروى البخاريّ عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطّاب عنده، فقال أبو بكر: إنّ عمر أتاني فقال: أنّ القتل قد استحرّ بقرّاء القرآن و إنّي أخشى أن يستحرّ القتل بالقرّاء في المواطن فيذهب كثير من القرآن و إنّي أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم؟ قال عمر: هذا و اللّه خير فلم يزل يراجعني حتّى شرح اللّه صدري لذلك و رأيت في ذلك الّذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنّك شابّ عاقل لا نتّهمك و قد كنت تكتب الوحي لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فتتبّع القرآن فاجمعه فو اللّه لو كلّفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ ممّا أمرني به من جمع القرآن ...
قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم؟ قال: هو و اللّه خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتّى شرح اللّه صدري للّذي شرح له صدر أبي بكر و عمر، فتتبّعت القرآن أجمعه من العسب و اللّخاف و صدور الرّجال، و وجدت آخر سورة التّوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ [ (9) التوبة: 128، 129] حتّى خاتمة براءة، فكانت الصّحف عند أبي بكر حتّى توفّاه اللّه تعالى، ثمّ عند عمر حياته، ثمّ عند حفصة بنت عمر.
و روى وكيع عن السّدي عن عبد خير عن عليّ قال: أعظم النّاس أجرا في المصاحف أبو بكر، كان أوّل من جمع بين اللّوحين.
ص: 146
قال الحاكم: و الجمع الثّالث هو: ترتيب السّور في زمن عثمان، فقد روى البخاريّ عن أنس أنّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان و كان يغازي أهل الشّام في فتح إرمينية و أذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان: أدرك الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود و النّصارى فأرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصّحف ننسخها في المصاحف ثمّ نردّها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد ابن ثابت و عبد اللّه بن الزّبير و سعيد بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، و قال عثمان للرّهط القرشيّين الثّلاثة: إذا اختلفتم أنتم و زيد بن ثابت في شي ء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنّما أنزل بلسانهم، ففعلوا حتّى إذا نسخوا الصّحف في المصاحف ردّ عثمان الصّحف إلى حفصة و أرسل إلى كلّ أفق بمصحف ممّا نسخوا، و أمر بما سواه من القرآن في كلّ صحيفة أو مصحف أن يحرق.
قال زيد: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ [ (33) الأحزاب: 23] فألحقناها في سورتها بالمصحف.
قال البلقينيّ: في القرآن من أسماء الأنبياء و المرسلين خمس و عشرون هم مشاهيرهم- آدم- قال ابن أبي خيثمة: عاش تسعمائة سنة و ستّين سنة، و كان بينه و بين نوح ألف و مائتا سنة.
و روى الطّبرانيّ عن أبي ذرّ قال: قلت يا رسول اللّه: من أوّل الأنبياء؟ قال: «آدم» قلت: ثمّ من؟ قال: «نوح و بينهما عشرة قرون».
و نوح و إدريس، و اختلف النّاس أيّهما أوّل؟ قال الحاكم: و أكثر الصّحابة على أنّ نوحا أوّل.
و قال ابن إسحاق: هو أوّل بني آدم، أعطي النّبوة، و هو أخنوخ بن يزيد بن أهلاليل ابن قينان بن ناشر بن شيت بن آدم.
و قال ابن وهب: هو جدّ نوح الذي يقال له: أخنوخ، و اختلف في ضبطه- فقيل:
بفتح الهمزة و سكون الخاء المعجمة و آخره معجمة أيضا- و قيل: خنوخ بفتح الخاء المعجمة و إسقاط الهمزة. و قيل: بإهمال أوّله.
ص: 147
و قال ابن الأثير: ولد و آدم حيّ قبل موته بمائة سنة و بعث بعد موته بمائتي سنة و عاش بعد نبوّته مائة و خمس سنين.
و قال ابن عبّاس: كان بين إدريس و نوح ألف سنة، و بعث نوح لأربعين سنة و مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين و عاش بعد الطّوفان ستّين سنة- رواه الحاكم.
و روى ابن جرير عن ابن عبّاس أنّه بعث و هو ابن ثلاثمائة و خمسين.
و قال ابن الأثير: هو نوح بن لمك بفتح اللام و سكون الميم و بالكاف. و قيل:
ملكان بفتح الميم و سكون اللام و ابن متوشلخ بضمّ الميم و فتح التّاء الفوقية و الواو و سكون الشين المعجمة و كسر اللام و بالخاء المعجمة- كذا ضبطه ابن الأثير، ابن إدريس.
و إبراهيم و هو: ابن آزر. قال ابن إسحاق: ولد على رأس ألفي سنة من آدم، و بينه و بين نوح عشرة قرون.
و قال ابن الأثير: ألف و مائة و اثنتان و أربعون سنة، و عاش مائة و خمسا و سبعين سنة، و قيل: مائتي سنة.
ولده: إسماعيل. و قال ابن الأثير: و عاش مائة و ثلاثين، و قيل: و سبعا و ثلاثين، و كان له حين مات أبوه تسع و ثمانون سنة.
و أخوه: إسحاق و ولد بعده، بأربع عشرة سنة و عاش مائة و ثمانين.
و ولده: يعقوب و عاش مائة و سبعا و أربعين سنة.
و ولده: يوسف. قال البلقيني: و هو مرسل بنصّ القرآن.
قلت: و قد قيل: إنّ الّذي في غافر ليس هو هو و إنّما هو حفيده يوسف بن أفراثيم، لبث فيهم نبيّا عشرين سنة، و عاش يوسف بن يعقوب مائة و عشرين سنة و بينه و بين موسى أربعمائة سنة.
و لوط: و هو ابن أخي إبراهيم، هاران بن آزر و قيل: أخو سارة.
و هود: و هو ابن عبد اللّه بن رباح بن جارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام، و قيل: ابن شالخ بن أرفخشد بن اسم كان بينه و بين نوح ثمانمائة سنة و عاش أربعمائة و ستين.
و صالح: و هو ابن عبيد بن آسيف بن ناسخ بن عبيد بن عامر بن ثمود بن عوص بن عاد بن إرم بن سام بينه و بين هود مائة سنة و عاش مائتين و ثمانين.
ص: 148
و شعيب و هو: ابن صيفون و قيل: ابن ملكاين.
و موسى: و هو ابن عمران بن فاهث بن يصهر بن عازر بن لاوى بن يعقوب بينه و بين إبراهيم خمسمائة و خمس و ستّون، و قيل: سبعمائة و عاش مائة و عشرين و أخوه هارون.
و داود و هو: ابن إيشا- بكسر الهمزة و سكون الياء التحتية و بالشين المعجمة- ابن عوبد بن باعر بن سلمون بن بخشون بن عمى بن يارب بن إرم بن خصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب، و بينه و بين موسى خمسمائة و تسع و ستون سنة و قيل: تسع و سبعون، و عاش مائة.
و ولده سليمان و عاش نيّفا و خمسين سنة و بينه و بين مولد النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم فيما قيل: نحو ألف و سبعمائة سنة.
و أيّوب و هو: ابن موص بن رعويل بن عيصو بن إسحاق عاش ثلاثا و ستّين، و قيل:
أكثر، و كانت مدّة بلائه سبع سنين.
و ولده: ذو الكفل فروى الحاكم عن وهب أنّ اللّه بعث بعد أيّوب ابنه بشر بن أيّوب نبيّا و سمّاه: ذا الكفل و أمره بالدّعاء إلى توحيده، و كان مقيما بالشّام عمره حتّى مات و عمره خمس و سبعون سنة.
و يونس: و هو ابن متّى و هي أمّه.
و إلياس: و هو ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى و قيل: هو إدريس و هو ضعيف.
و اليسع: و هو ابن حاطور.
و زكريّا: و هو ابن إذن، و قيل: برخيا و ولده يحيى و هو ابن خالة عيسى، قيل: ولد بعده بستّة أشهر.
و عيسى ابن مريم و هي: بنت عمران بن ناثان، كان بينه و بين موسى ألف و تسعمائة و خمس و عشرون سنة و بين مولده و الهجرة ستمائة و ثلاثون سنة، و رفع إلى السّماء و له ثلاث و ثلاثون سنة.
و محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم خاتم النّبيّين عليهم الصّلاة و السّلام، و قد ولد يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأوّل عام الفيل، و بعث يوم الاثنين على رأس أربعين سنة و أقام بمكة ثلاث عشرة سنة و هاجر إلى المدينة في ربيع الأوّل، و توفي في سنة إحدى عشرة من الهجرة في ربيع
ص: 149
الأوّل يوم الاثنين لليلتين خلتا منه، و قيل: لاثنتي عشرة. و فيه من أسماء الملائكة:
جبريل، و ميكائيل، و هاروت، و ماروت، إن صحّ أنّهما ملكان، هذا ما ذكره البلقيني.
قلت: و الرّعد، ففي التّرمذي من حديث ابن عباس أنّ اليهود قالوا للنّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم: أخبرنا عن الرّعد. فقال: ملك من الملائكة موكّل بالسّحاب.
و مالك: خازن جهنّم.
و قعيد: فقد ذكر مجاهد: أنّه اسم كاتب السّيّئات.
و السّجلّ: فقد قال السّهيلي و تابعوه: هو ملك في السّماء الثّالثة ترفع إليه الحفظة أعمال العباد في كلّ اثنين و خميس، و قيل: كان كاتبا للنّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم. رواه أبو داود و النّسائيّ عن ابن عبّاس.
و فيه من أسماء الصّحابة: زيد و هو ابن حارثة لا غير.
قلت: و السّجلّ على القول السّابق.
و فيه من أسماء المتقدّمين غير الأنبياء و الرّسل: عمران أبو مريم و أخوها هارون، و ليس بأخي موسى (1)، و أما الحديث الآخر: «فما أدري أ كان تبع لعينا أم لا؟» فأجيب عنه بأنّه قبل أن يوحى إليه أنّه آمن.
و لقمان: و قد قيل: إنّه كان نبيّا و الأكثر على خلافه.
و فيه من أسماء النّساء: مريم، قال السّهيلي: و قد تكرّر اسمها في نحو ثلاثين موضعا لحكمة و هو أنّ الملوك و الأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملأ و لا يبتذلون أسماءهنّ، بل يكنّون عن الزّوجة بالعرس و العيال و نحو ذلك، فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهنّ، و لم يصونوا أسماءهنّ عن الذكر، فلمّا قالت النّصارى في مريم ما قالوا صرّح اللّه باسمها و لم يكن تأكيدا للعبوديّة الّتي هي صفة لها، و تأكيدا لأنّ عيسى لا أب له، و إلّا لنسب إليه.
و فيه من أسماء الكفّار: إبليس و كان اسمه: عزازيل و معناه: الحارث، و كنيته: أبو مرّة، و قيل: أبو كردوس، و قارون، و جالوت، و هامان، و بشرى الذي ناداه الوارد المذكور في سورة يوسف بقوله: يا بُشْرى [ (12) يوسف: 19] في قول.
ص: 150
و آزر: أبو إبراهيم، و قيل: اسمه تارح و آزر لقب.
و فيه من أسماء القبائل: يأجوج، و مأجوج، و عاد، و ثمود، و مدين، و قريش، و الرّوم.
و فيه من الأقوام بالإضافة: قوم نوح، و قوم لوط، و أصحاب الرّسّ، و هم بقيّة من ثمود، و الرّسّ: قريتهم باليمامة، و قيل: بين المدينة و وادي القرى: و قيل: بئر بأنطاكية، و أصحاب الأيكة، و قوم تبّع.
و فيه من أسماء البلاد و الأمكنة و الجبال: بكة، و المدينة و هي: يثرب في الأحزاب، و بدر، و حنين، و مصر، و بابل، و طور سيناء جبل الجوديّ: و هو جبل بالجزيرة- و طوى و هو: بين مصر و مدين، و الأيكة و ليكة بفتح اللام بلد قوم شعيب، و الثّاني: اسم البلدة و الأوّل: اسم الكورة، و المؤتفكات و هي: بلاد قوم لوط، و الكهف و هو: غار في جبل بقرب طرسوس، و قيل: بين ايلة و عمّان دون فلسطين، و الرقيم: واد هناك، و قيل: اسم لكلبهم، و الأحقاف و هي: جبال الرّمل بين عمان و حضرموت.
و فيه من أسماء الأماكن الأخرويّة: الفردوس، و هو أعلى مكان في الجنّة، و علّيّون:
قيل: أعلى مكان في الجنّة، و قيل: اسم لما دوّن فيه أعمال صلحاء الثّقلين، و الكوثر و هو: نهر في الجنّة و في الموقف أيضا، و استمداده من الأوّل.
و سجّين: اسم لمكان أرواح الكفّار.
و غيّ: و هو واد في جهنّم رواه الحاكم عن ابن مسعود.
و الصّعود: جبل فيها، كما في حديث رواه التّرمذي.
و ويل: واد فيها، رواه التّرمذيّ أيضا.
و يحموم: جبل فيها، حكاه القرطبي.
و موبق: قال مجاهد: واد فيها، و قال عكرمة: نهر فيها.
و الفلق في حديث رواه أبو يعلى أنّه جهنّم، و قال ابن عبّاس: سجن في جهنّم، و قال كعب: بيت فيها.
و أثام: واد فيها، حكاه القرطبي.
و فيه من أسماء الأصنام: ودّ، و سواع، و يغوث، و يعوق، و نسر، و هي أصنام قوم نوح، و كانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشّيطان إليهم: أن
ص: 151
انصبوا إلى مجالسهم الّتي كانوا يجلسون فيها أنصابا و سمّوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتّى هلك أولئك و نسخ القلم، و اللات، و العزّى، و مناة، و هي: أصنام قريش، و بعل و هو: صنم قوم إلياس.
و فيه من أسماء الكواكب: الشّمس و القمر و الطّارق و الشّعرى.
أمّا الكنى: فليس في القرآن منها غير أبي لهب و اسمه: عبد العزّى و لذلك لم يذكر باسمه لأنّه حرام شرعا، و قيل: للإشارة إلى أنّه جهنّميّ. و أمّا الألقاب فمنها: إسرائيل ليعقوب و معناه: عبد اللّه، و قيل: صفوة اللّه، و قيل: سريّ اللّه، لأنّه أسرى لما هاجر.
و منها: المسيح لعيسى. و في معناه أوجه كثيرة ذكرتها في شرح الأسماء النبوية.
و نوح فإنّ اسمه: عبد الغفّار و لقّب به لكثرة نوحه على نفسه.
و ذو النّون: و هو يونس.
و ذو الكفل: إن صحّ أنّه بشر بن أيّوب.
و الرّوح: و روح القدس، و الأمين، ألقاب للملك الكريم جبريل عليه السّلام.
و ذو القرنين: و اسمه: الإسكندر، و لم يكن نبيّا، قيل: كان رجلا صالحا، و قيل:
اسمه: هرمس، و قيل: هرديس، و قيل: مرزبان بن مردبة، و قيل: هو الصّعب بن ذي يزن الحميري، و قيل: هو يوناني و سمّي ذا القرنين: لأنّه ملك فارس و الرّوم، أو دخل النّور و الظّلمة أو كان برأسه شبه القرنين، أو كان له ذؤابتان، أو رأى في النّوم أنّه أخذ بقرني الشّمس، أقوال.
و العزيز و اسمه: قطفير أو إطفير.
و طالوت: لقّب به لفرط طوله و اسمه: شاول بن أنبار بن ضرار.
و فرعون و اسمه: الوليد بن مصعب بن الريان و كنيته: أبو مرّة، و قيل: أبو العبّاس و هو فرعون الثّاني الّذي أرسل إليه موسى و كان قبله فرعون آخر و هو أخوه.
قابوس بن مصعب: ملك العمالقة، و لم يذكر في القرآن.
ص: 152
هذا النّوع مهمّ، و ذكر البلقينيّ منه أمثلة، و للنّاس فيه تصانيف منها: التّعريف و الأعلام للسّهيلي، و التّبيان لقاضي القضاة: بدر الدّين بن جماعة، و قد وقفت عليهما و على مختصر التّعريف لبعض الفضلاء و فيه زيادات عليه.
و قد حرّرتها في فضول:
فيما أبهم من رجل أو امرأة أو ملك أو جنّيّ، أو مثنّى، أو مجموع عرف أسماء كلّهم، أو من أو الّذي إذا كان نصّا للواحد، كقوله تعالى: إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً [ (2) البقرة: 30] هو آدم، و زوجته هي: حوّاء بالمدّ و قد تكرر وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً [ (2) البقرة: 72] اسمه: عاميل، إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ [ (2) البقرة: 246] هو شمويل بن بال علقمة يعرف بابن العجوز، و قيل فيه: شمعون، و قيل: هو يوشع و هو بعيد جدّا.
الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ [ (2) البقرة: 258] هو النّمرود بن كوس بن كنعان بن حام ابن نوح.
كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ [ (2) البقرة: 259] هو: عزير، أو أرميا، أو شعيا، أقوال.
امْرَأَتُ عِمْرانَ [ (3) آل عمران: 35] حنّة بالنّون بنت فاقوذ، (امرأت زكريّا) [ (3) آل عمران: 40] أشياع بنت فاقوذ فهي خالة مريم.
مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ [ (3) آل عمران: 193] هو النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم.
(الجبت) [ (4) النساء: 51] هو: حييّ بن أخطب، و قيل: اسم شيطان.
(الطاغوت) هو: كعب بن الأشرف.
وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً [ (4) النساء: 100] هو و إن كان عامّا لكن ذكرته في هذا الفصل لما روي عن عكرمة قال: طلبت اسم هذا الرّجل أربع عشرة سنة حتّى وجدته و هو: ضمرة بن العيص و يقال فيه: ضميرة، و قيل: هو جندب بن ضمرة، و قيل: خالد بن حزام ابن خويلد.
اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً [ (5) المائدة: 12] هم: شموع بن زكور من سبط روبيل، و شوقط بن حورى من سبط شمعون، و كالب بن يوفنا من سبط يهوذا، و بعورك بن يوسف من سبط أشاجره، و يوشع بن نون من سبط أفراثيم بن يوسف، و بلطي بن روفوا من سبط بنيامين، و كرابيل بن سورى من سبط زبالون، و كدى بن سؤسا من سبط منشا بن يوسف، و عمائيل
ص: 153
ابن كسل من سبط دان، و ستور بن ميخائيل من سبط أشير، و يوحنا بن وقوس من سبط نفتال، و أإل بن موخا من سبط كاذلوا.
قالَ رَجُلانِ [ (5) المائدة: 23] هما يوشع و كالب، ابْنَيْ آدَمَ [ (5) المائدة: 27] هما: قابيل و هابيل و هو المقتول، و القول بأنّهما ليسا لصلبه بل من بني إسرائيل باطل.
تَحْبِسُونَهُما [ (5) المائدة: 106] قال أصحاب المبهمات: الضّمير لتميم الدّاري و عدي بن بدّا النازل فيهما الآية.
قلت: الأولى أن يقال: هو راجع لاثنين في أول الآية و هي عامة و إن كان سبب نزولها قصتهما.
الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ [ (7) الأعراف: 175]؟ هو بلعم بن باعورا، و يقال فيه:
بلعام من بني إسرائيل و كان من الجبّارين.
وَ إِنِّي جارٌ لَكُمْ [ (8) الأنفال: 48] عنى سراقة بن مالك بن جعشم سيّد بني مدلج لأنه أتى في صورته.
إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ [ (9) التوبة: 40] هو أبو بكر الصّدّيق رضي اللّه عنه.
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي [التوبة: 75] هو الجدّ بن قيس.
وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ [ (9) التوبة: 75] هو ثعلبة بن حاطب.
وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ [ (9) التوبة: 107] هو أبو حنظلة الراهب.
الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا [ (9) التوبة: 118] كعب بن مالك، و هلال بن أميّة، و مرارة بن الرّبيع.
وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ [ (11) هود: 17] قيل: هو جبريل.
وَ نادى نُوحٌ ابْنَهُ [ (11) هود: 42] هو: كنعان بن حام، و قيل: يام.
(امرأت إبراهيم) [ (11) هود: 71] سارة.
و الغلام الّذي بشّرت به في الذّاريات: إسحاق بلا خلاف إذ لم تلد غيره.
(بنات لوط) [ (11) هود: 78] ريثا و رغوثا.
امرأته: والهة، قيل: واعلة.
ص: 154
إخوة يوسف أحد عشر: يهوذا، و شمعون، و لاوى، و روبيل، و تفتال، و كاذلوا، و شير، و دان، و قهاب، و بنيامين و هو شقيقة المراد حيث ذكر في السورة. و كبيرهم:
روبيل لأنّه أسنّهم، و قيل: شمعون أي رئيسهم، و قيل: يهوذا أي صاحب رأيهم و هو القائل الذي قال: لا تَقْتُلُوا [ (12) يوسف: 10] و هو البشير.
فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ [ (12) يوسف: 19] هو مالك بن دعر.
امْرَأَتُ الْعَزِيزِ [ (12) يوسف: 30] راعيل، و قيل: زليخا.
الَّذِي اشْتَراهُ [ (12) يوسف: 21] العزيز.
وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها [ (12) يوسف: 26] كان ابن عمّها، و قيل: ابن خالها و لم يسمّ، و في الحديث: إنّه كان طفلا في المهد.
وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ [ (12) يوسف: 36] هما: شرّهم و سرّهم و هو النّاجي.
وَ قالَ الْمَلِكُ هو الرّيان بن الوليد بن عمرو بن أراشة يجتمع مع فرعون في أراشة.
وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ [ (12) يوسف: 100] هما: أبوه و خالته ليّا، و إن كانت أمّة فاسمها: راحيل، قول إبراهيم: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ [ (71) نوح: 28] أبوه في القرآن، و أمّه: نوفا و قيل: ليوثا بنت كرنبا، و كانت مؤمنة.
كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها [ (16) النحل: 75] ريطة بنت سعيد بن زيد مناة بن تميم.
إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ [النحل: 103] هو جبر غلام الفاكه بن المغيرة، و قيل: مولى عامر ابن الحضرمي، و قيل: غير ذلك.
أَصْحابَ الْكَهْفِ [ (18) الكهف: 9] تمليخا و هو رئيسهم و القائل: فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ [ (18) الكهف: 16] و القائل: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ [ (18) الكهف: 19].
و مكسلمينا و هو القائل: كَمْ لَبِثْتُمْ [ (18) الكهف: 19] و مرطوش، و براشق، و أيونس، و أريسطانس، و شلططيوس.
وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ [ (18) الكهف: 32] هما: فوطس و تمليخا و هو الخير.
(فتى موسى) [ (18) الكهف: 60] يوشع.
فَوَجَدا عَبْداً [ (18) الكهف: 65] هو الخضر و اسمه: بليا بن ملكان بن فالغ بن شالخ ابن أرفخشد بن سام بن نوح، و قيل: أرميا، و قيل: اليسع، و قيل: غير ذلك.
ص: 155
وَراءَهُمْ مَلِكٌ [ (18) الكهف: 79] هو جيسور، و في رواية: حيسور بالحاء، و قيل:
حينور، و قيل: هدد بن بدد.
لَقِيا غُلاماً [ (18) الكهف: 74] قال في التبيان: اسمه: خش بود، و معناه بالفارسي:
طيّب.
(و أبواه) [ (18) الكهف: 80] الأب: كازيرا و الأمّ: سهوى.
لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ [ (18) الكهف: 82] هما: أصرم و صريم ابنا كاشح و امهما دينا.
وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ [ (19) مريم: 66] أبيّ بن خلف، أو الوليد بن المغيرة.
أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا [ (19) مريم: 77] هو العاص بن وائل، السَّامِرِيُّ [ (20) طه: 85] موسى بن ظفر، الدَّاعِيَ [ (54) القمر: 6] في طه و القمر، و (المنادي) [ (50) ق:
41] في ق: إسرافيل، (أمج موسى) [ (28) القصص: 10] بحانة بنت يصهر بن لاوى، و قيل: ياؤخا و به جزم السّهيلي.
وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ [ (28) القصص: 10] أخته مريم، و قيل: كلثوم.
وَ قَتَلْتَ نَفْساً [ (20) طه: 4] هو القبطي و اسمه: فاتون.
هذانِ خَصْمانِ [ (22) الحج: 19] هما خصم المؤمنين: علي و حمزة و عبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب، و خصم الكفّار: عتبة و شيبة ابنا ربيعة و الوليد بن عتبة، تبارزوا يوم بدر، الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ [ (24) النور: 11] عبد اللّه بن أبيّ، و هو الّذي تولّى كبره، و حمنة بنت جحش، و مسطح و اسمه: عوف بن أثاثة، و حسّان بن ثابت.
يَعَضُّ الظَّالِمُ [ (25) الفرقان: 27] هو عقبة بن أبي معيط، لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً [ (25) الفرقان: 28] هو صديقه أمية بن خلف أو أخوه: أبيّ بن خلف.
(إنّي وجدت امرأت تملكهم) [ (27) النمل: 23] هي بلقيس بنت هداد بن شرحبيل.
و قيل: دلقمة بنت أبي سرح بن أبي حدن.
قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ [ (27) النمل 39] هو: كودن، و قيل: ذكوان.
الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ هو آصف بن برخيا وزير سليمان و كاتبه و ابن خالته، و قيل: اسمه سطوم. و قيل: هو ضبة بن أد بن طابخة، و قيل: جبريل، و قيل: سليمان نفسه، و الكل ضعيف أو باطل.
تِسْعَةُ رَهْطٍ [ (27 النمل: 48] هم: مصدع بن دهر، و قيل: دهم، و قذار بن سالف، و هديم، و صواب، و رئاب، و دأب، و هرمى، ورعين بن عمرو.
ص: 156
امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ [ (28) القصص: 9] آسية بنت مزاحم، قيل: بنت عمه: و قيل: عمّة موسى.
نكتة: روى الزّبير بن بكار أن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم قال لخديجة: أشعرت أن اللّه زوّجني معك في الجنّة مريم بنت عمران و كلثوم أخت موسى و آسية امرأة فرعون.
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ [ (28) القصص: 8] اسم الملتقط له: طابوث، و قيل: هي امرأة فرعون، و قيل: ابنته رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ [ (28) القصص: 15] الإسرائيلي قيل: هو السّامريّ، و القبطيّ: تقدّم اسمه رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ [ (28) القصص: 20] قيل: طابوث، و قيل:
مؤمن آل فرعون و سيأتي، امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ [ (28) القصص: 23] هما: ليّا و صفوريا ابنتا شعيب عند الأكثر، و قيل: ابنتا ثيرون ابن أخي شعيب، و التي نكحها هي: صفوريا و هي الصغرى كما رواه الطبراني في الأوسط و الصغير. «ابن لقمان» تاران، و قيل: أنعم، و قيل: مشكم (ملك الموت) ذكر ابن جماعة في التبيان أن اسمه: عزرائيل و كذا رأيته بخطّ الشيخ: «وليّ الدّين العراقي» في تذكرته، و رواه الشيخ ابن حيّان في كتاب العظمة عن وهب، و ذكر الكرماني في مختصر المسالك أن كنية ملك الموت: يحيى.
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ [ (33) الأحزاب: 59] أمّا أزواجه اللّاتي اجتمعن عنده و مات عنهنّ فتسع: عائشة، و حفصة، و أمّ سلمة و اسمها هند، و ميمونة، و سودة، و أمّ حبيبة، و صفيّة، و جويرية، و زينب بنت جحش.
و بناته: فاطمة، و زينب زوجة أبي العاس بن الرّبيع، و رقيّة، و أمّ كلثوم زوجتا عثمان.
لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ [ (33) الأحزاب: 37] هو: زيد بن حارثة.
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ هي: زينب بنت جحش.
أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ [ (36) يس: 13] هم: شلوم، و صادق، و صدوق، و قيل بدلهما: شمعون و يحيى.
وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ [ (36) يس: 20] هو: حبيب بن موسى النّجار.
أَ وَ لَمْ يَرَ الْإِنْسانُ [ (36) يس: 77] هو: أبيّ بن خلف، أو أخوه أميّة، أو العاص بن وائل.
ص: 157
قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ [ (37) الصافات: 51] هما: الرّجلان في الكهف.
وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ [ (37) الصافات: 77] هم: سام و حام و يافث.
(الذّبيح) [ (37) الصافات: 101] إسماعيل على الصحيح، و قيل: إسحاق، و به جزم السّهيليّ و أنا الآن أميل إليه.
(نبؤا الخصم) [ (38) ص: 21] جبريل و ميكائيل.
عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً [ (38) ص: 34] قيل: شيطان اسمه: صخر و قيل: آصف.
وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ [ (40) غافر: 28] هو: شمعان جزم به السّهيلي و ابن جماعة، و قيل: حزقيل جزم به البلقيني، و قيل: جبر، و قيل: حبيب.
أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا [ (41) فصلت: 29] هما: إبليس و قابيل.
عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ [ (43) الزخرف: 21] عنوا الوليد بن المغيرة من مكّة، و عروة ابن مسعود الثّقفي من الطّائف.
وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ [ (46) الأحقاف: 10] قيل: موسى عليه السّلام و قيل:
عبد اللّه بن سلّام.
حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ [ (46) الأحقاف: 15] هو: أبو بكر رضي اللّه عنه، و أبوه: أبو قحافة عثمان بن عامر، و أمّه، و أمّ الخير سلمى بنت صخر، و ذرّيته: عبد اللّه و عبد الرحمن و أسماء و عائشة.
وَ الَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما [ (46) الأحقاف: 17] قيل: ولده عبد الرحمن و أنكرته عائشة.
أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى [ (53) النجم: 33] هو: الوليد بن المغيرة.
فَنادَوْا صاحِبَهُمْ [ (54) القمر: 29] هو: قذار.
الَّتِي تُجادِلُكَ [ (58) المجادلة 1] خولة بنت حكيم، و قيل: جميلة بنت ثعلبة، و زوجها: أوس بن الصّامت.
لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [ (66) التحريم: 1] هي سريّته مارية.
أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً [ (66) التحريم: 3] هي: حفصة.
ص: 158
إِنْ تَتُوبا [ (66) التحريم: 4] هما: حفصة و عائشة.
وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ [ (66) التحريم: 4] أبو بكر و عمر كما رواه الطّبرانيّ في الأوسط.
امْرَأَتَ نُوحٍ [ (66) التحريم: 10] والعة.
سَأَلَ سائِلٌ [ (70) المعارج: 1] هو النّضر بن الحارث.
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ [ (71) نوح: 28] أبوه: لمك بن متوشلخ و أمّه: شمخا بنت أنوش و كانا مؤمنين.
يَقُولُ سَفِيهُنا [ (72) الجن: 4] هو إبليس.
ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً [ (74) المدثر: 11] هو الوليد بن المغيرة.
فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى [ (57) القيامة: 31] هو عدي بن أبي ربيعة، و قيل: أبو جهل.
هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ [ (76) الإنسان: 1] هو آدم.
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ [ (78):] قيل: ملك لم يخلق اللّه بعد العرش أعظم منه رواه ابن جرير عن عليّ بن أبي طلحة، قيل: جبريل.
أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى [ (80) عبس: 2] هو ابن أمّ مكتوم عبد اللّه بن شريح بن مالك.
و قيل: اسمه: عمرو.
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ [ (81) التكوير: 19] جبريل! أو النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم قولان و سياق الآية يرجّح الأوّل.
وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ [ (90) البلد: 3] هو آدم و ذرّيته.
الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ [ (90) البلد: 4] هو أبو الأشد، كلدة بن أسيد.
انْبَعَثَ أَشْقاها [ (91) الشمس: 12] هو قدار.
فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ [ (91) الشمس: 13] هو صالح.
الَّذِي يَنْهى. عَبْداً [ (96) العلق: 9، 10] هو: أبو جهل، و العبد: النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم.
إِنَّ شانِئَكَ [ (108) الكوثر: 3] هو العاصي بن وائل، و قيل: أبو جهل.
(امرأت أبي لهب) [ (111) المسد: 4] أمّ جميل العوراء بنت حرب بن أميّة عمة معاوية.
ص: 159
الّذين سمّي بعضهم أو عرف عددهم، فمن ذلك ما يدخل تحت ضابط و له أمثلة.
أحدها: وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ [ (2) البقرة: 4] و الآيات الّتي في معناها في مؤمني أهل الكتاب منهم: عبد اللّه بن سلّام و النّجاشي و أصحابهما.
و سمّي من أصحاب ابن سلام: أسد و أسيد و أسلم و ثعلبة.
الثّاني: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ [ (2) البقرة: 6] الآية و ما في معناها فيمن حقّ عليه العذاب و أنّه لا يؤمن منهم: أبو جهل و أبو لهب و عتبة و شيبة.
وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ [ (3) آل عمران: 75]: كعب بن الأشرف، و حييّ بن أخطب و ابن أبي الحقيق.
الثّالث: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ [ (2) البقرة: 8] الآية في المنافقين و ما في معناها كآيات براءة و سورة المنافقين، و كانت عدّتهم ثلاثمائة رجل و مائة و سبعين امرأة أكثرهم يهود، و منهم: عبد اللّه بن أبيّ و هو القائل: لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ [ (63) المنافقون: 7] و الجد بن قيس، و معتب بن قشير بن مليل و هو الذي قال: لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ [ (3) آل عمران: 153]. و وديعة بن ثابت بن عمرو بن عوف و هو القائل:
إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ [ (9) التوبة: 65] و نبتل بن الحارث و هو القائل: هو أذن، و الحارث بن يزيد الطائي، و أوس بن قيظي و هو القائل: إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ [ (33) الأحزاب:
13]، و الحلاس بن سويد بن الصامت، و سعد بن زرارة، و سويد، و راعش، و قيس بن عمرو، و زيد بن اللصيب، و سلالة بن الحمام.
الرّابع: يا أَيُّهَا النَّاسُ حيث وقع فهم أهل مكّة.
الخامس: الأسباط هم: ذرّيّة يعقوب كالقبائل في العرب. و منه ما ليس له ضابط و هو كثير، الأنبياء و المرسلون.
و في مسند أحمد من حديث أبي أمامة مرفوعا: «الأنبياء مائة ألف و أربعة و عشرون ألفا، و الرّسل من ذلك: ثلاثمائة و خمسة عشر».
ص: 160
و من الأنبياء من لم يسمّ في القرآن: يوشع، و حنظلة بن صفوان نبيّ أصحاب الرّسّ، و حزقيل، و خالد بن سنان، و أرميا، و شعيا، و شمويل. و الملائكة لا يعلمهم إلّا اللّه كما أخبر بذلك في كتابه، و ممّن سمّي منهم و ليس في القرآن إسماعيل صاحب سماء الدّنيا، و ريافيل الّذي يطوي الأرض يوم القيامة.
أولاد إبراهيم: سمّي منهم: إسماعيل، و إسحاق، و مدين، و زمران، و سرج، و نفش، و نفشان، و كيسان، و سروج، و أميم، و لوطان، و نافس.
وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ [ (2) البقرة: 111] الآية، قاله يهود المدينة و نصارى نجران و كانوا ستّين، و سمّي منهم: السّيد و العاقب و أوس بن الحارث و خلف و خويلد، و يوفنا، و هم المذكورون في صدر آل عمران.
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ [ (2) البقرة: 189] سمّي منهم: معاذ بن جبل و ثعلبة بن غنم.
يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ [ (2) البقرة: 215] سمّي منهم: عمرو بن الجموح.
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ [ (2) البقرة: 219] سمّي منهم: عمر، و معاذ.
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ [ (2) البقرة: 222] سمّي منهم: أسيد بن الحضير، و عبّاد ابن بشر.
الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ .. [البقرة: 243] قيل: ثلاثون ألفا، و قيل:
سبعون، و قيل: ثمانون.
فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ [ (2) البقرة: 249] قيل: كانوا سبعين ألفا، و الّذين لم يشربوا و جاوزوا معه ثلاثمائة و ثلاثة عشر و هم عدد أهل بدر.
مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ [ (2) البقرة: 253] سمّى أصحاب المبهمات ممّن كلّم اللّه موسى لا غير.
قلت: و منهم: آدم كما ثبت في الحديث و محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ [ (3) آل عمران: 23] الآية، سمّي منهم: النّعمان بن عمرو، و الحارث بن يزيد.
وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا [ (3) آل عمران: 72] سمّي منهم: عبد اللّه بن الضّيف، و عديّ بن زيد، و الحارث بن عوف.
ص: 161
كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ [ (3) آل عمران: 86] سمّي منهم: الحارث ابن سويد بن أسلم.
إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ [ (3) آل عمران: 100] سمّي منهم: عمرو بن شامس و أوس بن قيظي و جبار بن صخر.
إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ [ (3) آل عمران: 122] هما: بنو حارثة من الأوس، و بنو سلمة من الخزرج.
و مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا [ (3) آل عمران: 152] هم الّذين فرّوا من المشركين و كانوا سبعة و ثلاثين رجلا.
وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ [ (3) آل عمران: 152] الّذين ثبتوا ثلاثة عشر منهم: عبد اللّه ابن جبير.
وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ [ (3) آل عمران: 154] هم المنافقون.
الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ [ (3) آل عمران: 172] هم الخارجون إلى بدر ثانيا بعد أحد و كانوا سبعين.
الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ [ (3) آل عمران: 181] منهم: فنحاص اليهودي.
الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا [ (3) آل عمران: 183] منهم: كعب بن الأشرف و فنحاص.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ [ (4) النساء: 77] سمّي منهم: طلحة بن عبيد اللّه، و عبد الرحمن بن عوف.
إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ [ (4) النساء: 90] هم بنو مدلج دخلوا في صلح خزاعة.
أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [ (4) النساء: 90] هم هلال بن عويمر الأسلمي و قومه.
سَتَجِدُونَ آخَرِينَ [ (4) النساء: 91] هم قوم من أسد و غطفان.
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ [ (4) النساء: 98] سمّي منهم: ابن عبّاس و أمّه أمّ الفضل لبابة بنت الحارث الهلاليّة أخت ميمونة.
الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ [ (4) النساء: 107] هم: طعمة بن أبيرق و أقاربه منهم إخوته:
بشر و بشير و مبشّر و ابن عمّهم أشير بن عروة بن أبيرق.
ص: 162
وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ [ (4) النساء: 127] سمّي من المستفتين: خولة بنت حكيم سألت عن بنات أخيها.
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [ (4) النساء: 176] سمّي منهم: جابر بن عبد اللّه.
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ [ (5) المائدة: 4] سمّي منهم: عديّ بن حاتم الطائي.
إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا [ (5) المائدة: 11] سمّي منهم: عمرو بن جحاش اليهودي.
قَوْماً جَبَّارِينَ [ (5) المائدة: 22] هم العمالقة.
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ [ (5) المائدة: 33] هم العرنيّون و كانوا ثمانية.
وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ [ (5) المائدة: 41] هم: بنو قينقاع، و قيل: قريظة.
لِقَوْمٍ آخَرِينَ [ (5) المائدة: 41] هم أهل خيبر.
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ [ (5) المائدة: 54] فسّرهم النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم بقوم أبي موسى الأشعريّ، رواه الحاكم.
وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ [ (5) المائدة: 83] هم وفد الحبشة و كانوا سبعين، و سمّي منهم: إبراهيم، و إدريس، و أبو خزاعة، و الأشرف، و السّمن، و تميم، و تمام، و دريد.
وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى [ (5) المائدة: 110] أخرج: سام بن نوح، و رجلين و امرأة، و جارية.
الْحَوارِيِّينَ [ (5) المائدة: 111] سمّي منهم: بطرس، و بولس، و اندارس، و يحنّس، و بوطا، و زرنب بن تملا، و فيلبس، و يعقوبس، و نسمى، و توماس، و إيريلها، و يهودا.
يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ [ (6) الأنعام: 25] سمّي من قائلي ذلك: النّضر بن الحارث، و كذا قوله تعالى: وَ إِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ [ (8) الأنفال: 32]، وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ [ (6) الأنعام: 93]، وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ [ (6) الأنعام: 52] و نحوها في الكهف سمّي منهم: بلال، و عمّار.
إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْ ءٍ [ (6) الأنعام: 91] سمّي منهم: مالك بن الضيف اليهودي.
ص: 163
قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى [ (6) الأنعام: 124] سمّي منهم: الوليد بن المغيرة، و أبو جهل.
الّذين آمنوا مع صالح مائة و عشرة.
السّحرة قيل: خمسة عشر ألفا، و قيل: سبعون ألفا، و قيل: أربعمائة، و قيل:
تسعمائة، و رؤساؤهم أربعة: عاد، و ساتور، و حطحط، و المصفى.
عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ [ (7) الأعراف: 138] هم من كنعان، و قيل: من لخم.
وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ [ (7) الأعراف: 181] هي أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم.
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ [ (8) الأنفال: 1] سمّي منهم: سعد بن أبي وقّاص.
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى [ (8) الأنفال: 70] كانوا سبعين منهم:
العبّاس، و عقيل، و نوفل بن الحارث.
إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [ (9) التوبة: 4] هم بنو كنانة، و بنو ضمرة، و بنوا مدلج، و بنوا الذليل.
وَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلى مَنْ يَشاءُ [ (9) التوبة: 15] منهم: أبو سفيان، و معاوية و عكرمة بن أبي جهل.
الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ [ (9) التوبة: 92] منهم: بنو مقرّن المزني، قيل: كانوا سبعة:
علبة بن يزيد، و عبد اللّه بن المغفل، و العرباض بن سارية، و عبد الرحمن بن عمرو، و سالم بن عمير، و معقل، و عائذ بن عمرو.
وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [ (9) التوبة: 60] سمّي منهم: عبد اللّه بن يربوع، و عمرو بن مردان، و العباس بن مرداس، و علاء بن الحارثة، و قيس بن عديّ.
وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ [ (9) التوبة: 98] هم: نفر من بني أسد و تميم.
وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ [ (9) التوبة: 99] هم: بنو مقرن.
وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ [ (9) التوبة: 100] قيل: من صلّى إلى القبلتين، و قيل: أهل بدر، و قيل: البيعة.
وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا [ (9) التوبة: 102] هم سبعة منهم: أبو لبابة، و أوس بن ثعلبة و وديعة بن حرام.
ص: 164
وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ [ (9) التوبة: 106] هم الثّلاثة الّذين خلّقوا.
فِيهِ رِجالٌ [ (9) التوبة: 108] هم بنو عمرو بن عوف من الأوس.
وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ [ (11) هود: 40] قيل: ثمانون نصفهم رجال و نصفهم نساء، و قيل: ثمانية و سبعون، و قيل: عشرة.
جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى [ (11) هود: 69] هم: اثنا عشر ملكا منهم: جبريل و ميكائيل و إسرافيل و هم الّذين في العنكبوت و الذّاريات و الحجر.
وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ [ (12) يوسف: 30] هم خمسة: امرأة السّاقي، و الحاجب، و الخبّاز، و السّجّان، و صاحب الدّوابّ.
كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ [ (15) الحجر: 95] هم: الوليد بن المغيرة، و العاص، و الأسود ابن المطلب، و الأسود بن عبد يغوث، و عديّ بن قيس.
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا [ (16) النحل: 110] سمّي منهم: أبو جندل بن سهيل.
بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا [ (17) الإسراء: 5] هم أهل بابل و عليهم بخت نصّر في المرّة الأولى.
سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ [ (18) الكهف: 22] هو و الّذي بعده لنصارى نجران و الثّالث للمسلمين.
أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ [ (18) الكهف: 50] سمّي من أولاد إبليس: الأبيض و هامة بن الأبيض، و بلزون الموكّل بالأسواق.
فَكانَتْ لِمَساكِينَ [ (18) الكهف: 79] قيل: سبعة و قيل: عشرة.
وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً [ (18) الكهف: 86] هم: أهل جابرس من نسل مؤمني ثمود.
تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ [ (18) الكهف: 90] هم: أهل جابلق من نسل مؤمني عاد، و قيل:
هم الزّنج.
يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا [ (22) الحج: 75] قال في التّبيان: كجبريل و ميكائيل
ص: 165
و غيرهم، و كأنّ المراد بالرّسل المتصرّفون في أمور اللّه لا المرسلون إلى الأنبياء خاصّة.
وَ أَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ [ (25) الفرقان: 4] عنوا يسارا مولى العلاء بن الحضرمي، و جبرا، و عداسا مولى حويطب.
لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ [ (36) الشعراء: 54] قيل: ستّمائة ألف و سبعون ألفا، و قلّلهم باعتبار جنده فقد كانوا ألف ألف و خمسمائة ألف.
يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي [ (27) النمل: 32] كان أهل مشورتها ثلاثمائة و ثلاثة عشر.
أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا [ (29) العنكبوت: 2] هم المؤذون على الإسلام منهم: عمّار ابن ياسر و أبوه.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ [ (31) لقمان: 6] سمّي منهم: النّضر بن الحارث.
إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ [ (33) الأحزاب: 9] هم الأحزاب: قريش و قائدهم أبو سفيان، و غطفان و قائدهم عتبة بن حصن، و قريظة و النّضير.
مَنْ قَضى نَحْبَهُ [الأحزاب: 23] سمّي منهم: حمزة، و مصعب، و أنس بن النّضر.
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ [ (33) الأحزاب: 23] سمّي منهم: عثمان، و طلحة، و سعيد.
الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ [ (33) الأحزاب: 26] هم قريظة.
وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ [ (33) الأحزاب: 50] هي عامّة لأنّها نكرة في سياق الشّرط، و سمّي من الواهبات: خولة بنت حكيم، و أمّ شريك العامريّة.
وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ [ (38) ص: 6] سمّي منهم: الوليد، و العاص، و أبو جهل، و النّضر، و شيبة، و أخوه عتبة، و ابنه الوليد، و أبو البختري، و مطعم بن عدي و مخرمة بن نوفل، و سهيل بن عمرو، و هشام بن عمرو، و ربيعة بن الأسود، و عديّ بن قيس، و حويطب بن عبد العزّى، و الحارث بن قيس، و عامر بن خالد، و الأخنس بن شريق، و عبد اللّه بن أميّة، و نبيه بن الحجاج، و أخوه منبّه، و أبيّ بن خلف، و قرط بن عمرو، و عمير بن وهب.
قوله: إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ في النّمل و الزّمر [النمل، و الزمر: 87. 68] قيل: جبريل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت، و قيل: هم و حملة العرش الثّمانية، و قيل: رضوان،
ص: 166
و الحور، و مالك و الزّبانية، و قيل: الشّهداء، و قيل: المستثنى في الفزع: الشّهداء و في الصّعق: الملائكة المذكورون.
وَ قالُوا أَ آلِهَتُنا [ (43) الزخرف: 58] سمّي منهم: ابن الزّبعرى.
نَفَراً مِنَ الْجِنِّ [ (46) الأحقاف: 29] هم من جن نصيبين أو الجزيرة: سبعة، و قيل:
تسعة منهم: زوبعة، و سرّق، و عمرو بن جابر، و شاصر، و ماصر، و منشى، و ماشي، و الأخف.
أُولُوا الْعَزْمِ [ (46) الأحقاف: 35] هم: محمّد، و إبراهيم، و نوح، و موسى، و عيسى، و قيل: الثّمانية عشر الّذين في الأنعام، و قيل أربعة: إبراهيم و موسى و داود و عيسى، و قيل: نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسى، و قيل: نوح و إبراهيم و إسحاق و يعقوب و يوسف و أيّوب.
يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ [ (47) محمد: 38] فسّروا في حديث بقوم سليمان.
إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ [ (49) الحجرات: 4] هم أعراب من بني تميم منهم: الأقرع بن حابس، و الزّبرقان بن بدر، و عيينة بن حصن، و عمرو بن الأهتم، و خالد ابن مالك، و قعقاع بن معبد.
قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا [ (49) الحجرات: 14] هم قوم من بني أسد.
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا [ (59) الحشر: 2] هم: بنو النّضير.
أَصْحابُ الْجَنَّةِ [ (59) الحشر: 20] هم قوم من اليمن إخوة.
أَصْحابُ الْأُخْدُودِ [ (85) البروج: 4] هم: ذو نواس زرعة بن أسعد الحميري و أصحابه.
بِأَصْحابِ الْفِيلِ [ (105) الفيل: 1] هم الحبشة، قائدهم: أبرهة الأشرم و دليلهم: أبو رغال الثّقفي.
ص: 167
وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ [ (2) البقرة: 50] هو القلزم و كنيته: أبو خالد.
ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ [ (2) البقرة: 58] هي: أريحا، و قيل: بيت المقدس، و قيل:
البلقاء، و قيل: الرّملة و فلسطين.
مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ [ (2) البقرة: 249] هو نهر فلسطين أو الأردن.
مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ [ (2) البقرة: 259] هي بيت المقدس.
أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ [ (2) البقرة: 260] طاوس، و حمامة، و غراب، و ديك، و قيل:
بطة، و نسر بدل الأوّلين.
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ [ (5) المائدة: 19] هو الخفّاش.
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها [ (4) النساء: 75] مكة.
ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ [ (5) المائدة: 21] هي إيليّا، و هو بيت المقدس. و قيل:
أريحا، و قيل: فلسطين، و قيل: دمشق.
رَأى كَوْكَباً [ (6) الأنعام: 76] هي: الزهرة و قيل: المشتري.
الْأَعْرافِ: سور بين الجنّة و النّار.
سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ [ (7) الأعراف: 145] قيل: ديار عاد و ثمود و قيل: جهنم.
و قيل: (مصر) دار فرعون، و قيل: إنّ قائله إنّما قال: أي مصيرهم فتصحّفت بمصر حتّى استعظم ذلك بعضهم. قلت: و ما في هذا مما يستعظم.
وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ [ (7) الأعراف: 163] هي: أيلة، و قيل: هي طبريّة فيكون البحر نهر الأردن.
ص: 168
تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ [ (7) الأعراف: 143] هو الطّور- و كذا وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ [ (7) الأعراف: 171]، إِذْ هُما فِي الْغارِ [ (9) التوبة: 40] هو في جبل ثور.
لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى [ (9) التوبة: 108] هو مسجد قباء، و قيل: مسجد المدينة.
أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً [ (12) يوسف: 4] تفسيرها في حديث مرفوع في مسند البزّار و الطّبراني، و قد كنت توقّفت فيها إذ لم أجدها مضبوطة لا في خطّ الحافظ أبي الحسن الهيثميّ، و شيخ الحفّاظ أبي الفضل بن حجر و سألت عنها أهل الميقات فلم يعرفوا منها إلّا القليل حتّى رأيتها مضبوطة بخطّ مختصر التّعريف و هي: الخرثان، و طارق، و الدّيّال، و قابس، و المليح، و الضّروح، و ذو الكتفان، و ذو الفرغ، و الفيلق و ثاب، و العمودان.
غَيابَتِ الْجُبِّ [ (12) يوسف: 15] هو جبّ في الأردن، و قيل: بيت المقدس.
جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً [ (15) الحجر: 16] هي: اثنا عشر: الحمل، و الثّور، و الجوزاء، و السّرطان، و الأسد، و السّنبلة، و الميزان، و العقرب، و القوس، و الجدي، و الدّلو، و الحوت و هي المراد بالبروج حيث ورد في القرآن إلّا في قوله: وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ [ (4) النساء: 78].
وَ جاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ [ (15) الحجر: 67] هي: سدوم أكبر مدائنهم، و البواقي: صعده و عمره، و دوما.
إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ [ (16) النحل: 7] قيل مكّة.
وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ [ (16) النحل: 16] هي: الثّريّا، و الفرقدان، و بنات نعش، و الجدي، و قيل: المراد الجنس.
وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ [ (18) الكهف: 18] اسمه: قطمير.
بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ [ (18) الكهف: 19] هي: طرسوس بفتح الراء.
مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ [ (18) الكهف: 60] قيل: بحر فارس و الرّوم، و قيل: بحر العرب و بحر الزقاق، و قيل: بحر الأردن و بحر القلزم، و قيل: طنجة و إفريقية.
أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ [ (18) الكهف: 77] قيل: أنطاكية، و قيل: أيلة، و قيل: النّاصرة قرية بالشام.
ص: 169
مَكاناً قَصِيًّا [ (19) مريم: 22] هو وادي بيت لحم.
سَرِيًّا [ (19) مريم: 24] هو نهر.
فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ [ (20) طه: 39] هو النّيل.
الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها [ (21) الأنبياء: 81] الشام.
الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ [ (21) الأنبياء: 74] سدوم.
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ [ (21) الأنبياء: 105] قيل: أرض الدّنيا، و قيل:
أرض الجنّة، و قيل: الأرض المقدّسة.
وَ آوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ [ (23) المؤمنون: 50] قيل: دمشق و غوطتها، و قيل: بيت المقدس، و قيل: الرّملة، و قيل: مصر، و قيل: النّاصرة.
وَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ [ (25) الفرقان: 53] قيل: هو بحر معروف يلتقي فيه الماء الملح و العذب.
وَ مَقامٍ كَرِيمٍ [ (26) الشعراء: 57] هو الفيّوم، و قيل: أرض مصر.
وادِ النَّمْلِ [ (27) النمل: 18] هو بالشّام و قيل: بالطّائف، و قيل: باليمن.
قالَتْ نَمْلَةٌ [النمل: 18] قيل: اسمها: حرميا و قيل: طاخية. قال السهيليّ: و كيف يتصور ذلك و النمل لا يسمّي بعضهم بعضا و لا يمكن للآدميين تسمية واحدة منها بعينها إذ ليس ممّا يدخل تحت ملكهم كالخيل و الكلاب، و إن صحّ ذلك فلعلّها سميّت في بعض كتب اللّه و عرفها الأنبياء أو بعضهم قبل سليمان، و خصّها بالتّسمية لصدور هذه الحكم العجيبة منها.
قلت: استشكال السّهيليّ لا معنى له فقد قال الفريابيّ في تفسيره حدّثنا سفيان عمّن حدّثه عن مجاهد في قوله: أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ [ (6) الأنعام: 38] قال: أصنافا مصنّفة تعرف بأسمائها إلّا أن يكون مراده أسماء الأجناس.
لا أَرَى الْهُدْهُدَ [ (27) النمل: 20] قيل: اسمه يعفور و قال الحسن: اسمه عفير.
وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ [ (27) النمل: 22] المراد هنا: المدينة و هي قريبة من صنعاء.
وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ [ (28) القصص: 15] هي منف من أرض مصر.
ص: 170
لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ [ (28) القصص: 85] هي مكّة.
غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ [ (30) الروم: 2، 3] و هي: أذرعات، و بصرى، و هي أدنى أرض الشّام إلى أرض العرب، و قيل: أرض الأردن و فلسطين، و قيل: الجزيرة لأنها أدنى أرض الرّوم إلى أرض فارس. دَابَّةُ الْأَرْضِ [ (34) سبأ: 14] هي الأرضة و الأرض:
مصدر أرضت الخشبة لا الأرض المعروفة.
أَصْحابَ الْقَرْيَةِ [ (36) يس: 13] هي: أنطاكية.
وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ [ (37) الصافات: 107] هو الكبش الذي قرّبه هابيل.
فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ [ (37) الصافات: 145] ساحل قرية من الموصل.
رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ [ (43) الزخرف: 31] مكّة و الطّائف.
وَ هذِهِ الْأَنْهارُ [ (43) الزخرف: 51] هي أربعة: نهر الملك، و نهر طولون، و نهر دمياط، و نهر تنّيس.
يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ [ (50) ق: 41] هو صخرة بيت المقدس أقرب الأرض إلى السّماء.
الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ [ (52) الطور: 4] اسمه: الضّراح في السّماء السّابعة و قيل: في السادسة. و قيل: الأولى جهنّم.
الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ قيل: بحر تحت العرش. و قيل: في جهنم.
وَ النَّجْمِ [ (53) النجم: 1] هو الثّريّا.
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى [ (59) الحشر: 7] هي: فدك، و بدر الصّفراء، و نحوها.
وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ [ (59) الحشر: 9] هي المدينة.
قَسْوَرَةٍ [ (74) المدثر: 51] هي الأسد، رواه البزّار عن أبي هريرة.
بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْكُنَّسِ [ (81) التكوير: 15، 16] هي: زحل، و المشتري، و المرّيخ، و الزّهرة، و عطارد.
النَّجْمُ الثَّاقِبُ [ (86) الطارق: 3] قيل: زحل، و قيل: الثّريّا.
ص: 171
جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ [ (89) الفجر: 9] وادي الحجر، و قيل: وادي القرى.
لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ [ (90) البلد: 1] هو مكة، و كذا: وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ [ (95) التين: 3].
الْفِيلِ [ (105) الفيل: 1] فحمود (الغاسق) [ (113) الفلق: 3] القمر كما في الحديث.
ص: 172
يَوْمِ الدِّينِ [ (1) الفاتحة: 3] هو يوم القيامة و كذا سائر الأيام الّتي في القرآن إلّا ما نذكره.
وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً [ (7) الأعراف: 142] هي: ذو القعدة من ذي الحجة و هي الّتي في سورة الأعراف.
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ [ (2) البقرة: 184] زعموها سبعة و قيل: أربعين.
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ [ (2) البقرة: 197] هي شوّال، و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة كما رواه الحاكم عن ابن عمر.
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ [ (2) البقرة: 184] هي أيّام التّشريق الثّلاثة بعد يوم النّحر.
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ [ (2) البقرة: 217] هو رجب.
تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ [ (3) آل عمران: 155] هو يوم أحد.
لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ [ (5) المائدة: 2] المراد به: ذو القعدة.
عَلى فَتْرَةٍ [ (5) المائدة: 19] هي مدّة ما بين عيسى و النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم ستمائة سنة و قيل:
خمسمائة و ستون.
يَوْمَ الْفُرْقانِ [ (8) الأنفال: 41] هو يوم بدر، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ [ (9) التوبة: 2] هي من عاشر ذي الحجّة سنة تسع إلى آخر ربيع الآخر سنة عشر، و قيل: من عاشر ذي القعدة.
وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ [ (9) التوبة: 25] كان في شوّال سنة ثمان.
بَعْدَ عامِهِمْ هذا [ (9) التوبة: 28] هو سنة تسع من الهجرة.
أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [ (9) التوبة: 36] هي: رجب، و المحرّم، و ذو القعدة، و ذو الحجة.
ص: 173
فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ [ (12) يوسف: 42] قيل: سبع و كذلك في الروم.
مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ [ (20) طه: 59] قيل: يوم عاشوراء، و قيل: يوم عيد لهم قبل النّيروز و وافق يوم السّبت.
أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ [ (22) الحج: 28] هي عشر ذي الحجّة، و قيل: أيّام النّحر، و قيل:
يوم عرفة و النّحر و التّشريق.
يَوْمِ الظُّلَّةِ [ (26) الشعراء: 189] يوم أهلك قوم شعيب أظلّهم سحاب فأمطر عليهم نارا.
عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها [ (28) القصص: 15] قيل: وقت القائلة، و قيل: بين المغرب و العشاء.
خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ [ (41) فصلت: 9] هما يوم الأحد و الاثنين.
فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ [ (41) فصلت: 10] أي تمامها بالثلاثاء و الأربعاء.
سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ [ (41) فصلت: 12] هما: الخميس و الجمعة.
إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ [ (44) الدخان: 3] هي ليلة القدر و قيل: ليلة النّصف من شعبان.
فِي يَوْمِ نَحْسٍ [ (54) القمر: 19] هو يوم الأربعاء، و نحسه عليهم لا في ذاته.
سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ [ (69) الحاقة: 7] قيل: هي أيّام الأعجاز في عجز الشّتاء و أوّلها: الأربعاء و قيل: الجمعة.
وَ الْفَجْرِ [ (89) الفجر: 1] هو الصّبح مطلقا، و قيل: صبح يوم النّحر، و قيل: هو المحرّم لأنّه فجر السّنة، رواه البيهقي عن ابن عبّاس.
وَ لَيالٍ عَشْرٍ [ (89) الفجر: 2] هي: عشر ذي الحجة، و قيل: عشر المحرّم، و قيل:
العشر الأخير من رمضان.
وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ [ (89) الفجر: 3] قيل: اليومان بعد النّحر و الثّالث و قيل: يوم عرفة، و النّحر، و ليلة جمع، و قيل: غير ذلك.
وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ [ (89) الفجر: 4] قيل هي ليلة جمع.
ص: 174
وَ الضُّحى [ (93) الضحى: 1، 2] قيل: هو الضّحى الّذي كلّم اللّه فيه موسى.
وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى [ (93) الضحى: 2] قيل: هي ليلة المعراج.
لَيْلَةِ الْقَدْرِ فيها نيّف و أربعون قولا لا يحتملها هذا المحل.
و أرجحها في مذهبنا أنّها مختصّة بالعشر الأخير و أنّها ليلة الحادي أو الثّالث و العشرين، و عندي أنّها لا تلتزم ليلة بعينها و قد قاله جماعة و نقل عن نصّ الشّافعيّ، و اختاره النّوويّ في شرح المهذّب.
هذا النّوع من زيادتي، و قد وقفت فيه على تصنيف فيه لبعض القدماء و قد روينا عن عليّ بن أبي طالب قال: ما من رجل من قريش إلّا قد نزلت فيه طائفة من القرآن، و كنت عزمت على سردهم هنا مرتّبين على حروف المعجم ثمّ رأيت أنّه يلزم منه تكرار كثير لأن غالب من نزل فيه القرآن ذكر في هذا الكتاب خصوصا في المبهمات فرأيت أن أذكر هنا بعض ما لم يتقدّم له ذكر.
أبو بكر الصّديق: نزل فيه آيات منها: آخر سورة اللّيل.
عمر بن الخطّاب: نزل فيه آيات منها: موافقاته المشهورة كقوله: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى [ (2) البقرة: 125].
عثمان بن عفّان: نزل فيه ...
عليّ بن أبي طالب نزل فيه: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ [ (5) المائدة: 55] الآية.
أبي بن كعب نزل فيه: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [ (3) آل عمران: 110] كذا قال صاحب الكتاب المشار إليه.
أسامة بن زيد: نزل فيه: وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ [ (4) النساء: 94].
أسعد بن زرارة: ممّن نزل فيه: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ [ (2) البقرة: 143] و كذا أبو أمامة من بني النجار، و البراء بن معرور، و الأخنس بن شريق الثقفي الكافر: نزل فيهم:
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ [ (2) البقرة: 204].
أربد بن قيس الجعفي نزل فيه: وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ [ (13) الرعد: 13] الآية.
ص: 175
بشير بن النّعمان نزل فيه: وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً [ (2) البقرة: 224]. تميم بن أوس الدّاري نزل فيه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ [ (5) المائدة: 106] و في عديّ بن زيد ثوبان مولى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم نزل فيه: وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ [ (4) النساء: 69] الآية.
حاطب بن أبي بلتعة نزل فيه: أوّل الممتحنة.
حارثة بن زيد من بني عامر بن لؤيّ هو مقتول عياش الّذي نزل فيه: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً [ (4) النساء: 92].
حارثة بن زيد الأسديّ: نزلت فيه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ [ (5) المائدة: 101].
حسّان بن ثابت: نزل فيه آخر الشّعراء: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا.
حنظلة بن شمردل: نزل فيه: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى صهيب بن سنان الرّومي نزل فيه: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ [ (2) البقرة: 207].
صبيح مولى حويطب: نزل فيه: فَكاتِبُوهُمْ [ (24) النور: 33] عاصم بن عدي: نزل فيه آية اللّعان.
عثمان بن أبي طلحة: نزل فيه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها [ (4) النساء: 58].
عيينة بن حصن: نزل فيه: وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ [ (18) الكهف: 28].
كعب بن عجرة نزل فيه: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً [ (2) البقرة: 196].
عائشة: نزل فيها عدّة آيات، منها: قصّة الإفك.
أمّ سلمة: نزل فيها: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ [ (3) آل عمران: 32] الآية.
أميمة بنت الحارث: نزل فيها: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ [ (2) البقرة: 230] الآية.
و قد ذكر في الكتاب الذي صدّرنا بذكره جماعة مع ما نزل في كلّ منهم لكن غالبه لا تركن النّفس إليه لأن بعضه ثبت في التّفاسير المعتمدة و الأحاديث الصّحيحة خلافه، و بعضه
ص: 176
لا يدري ما مستنده فيه و أرجو أن أصرف العناية إلى تحرير كتاب في هذا المعنى متتبّعا له من الأحاديث و مشهور التّفاسير إن شاء اللّه تعالى.
هذا النّوع من زيادتي، و هو من أنواع علوم الحديث، و موضوعه ثمّ: ذكر وفيات المشاهير من الصّحابة و أئمة الحديث، و نذكّر هنا: وفيات المشاهير من القرّاء و المفسّرين ممن ذكرناهم في النّوع الخامس و العشرين و تاليه و النّوع الثّالث و التّسعين.
تقدّمت وفاة النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم في الأسماء. و توفّي أبو بكر سنة ثلاث عشرة. و عمر آخر يوم من سنة ثلاث و عشرين شهيدا. و عثمان: سنة خمس و ثلاثين و مقتولا ظلما. و عليّ: سنة أربعين مقتولا شهيدا. و سالم: مولى أبي حذيفة يوم اليمامة شهيدا. و معاذ بن جبل: سنة سبع عشرة. و أبيّ: سنة تسع عشرة. و ابن مسعود و أبو الدرداء: سنة اثنتين و ثلاثين. و زيد ابن ثابت: سنة خمس و أربعين. و أبو موسى الأشعري: سنة اثنتين و خمسين. و أبو هريرة:
سنة سبع، و قيل: ثمان، و قيل: تسع و خمسين. و علقمة: سنة إحدى و ستّين. و مسروف:
سنة اثنتين و ستّين. و زرّ: سنة اثنتين و ثمانين. و عبيدة: سنة اثنتين و سبعين.
و ابن عبّاس: سنة ثمان و ستّين.
و أبو العالية و سعيد بن المسيّب: سنة ثلاث و تسعين. و سعيد بن جبير: سنة خمس و تسعين شهيدا قتله الحجّاج لعنه اللّه. و مجاهد: سنة مائة. و الضّحاك بن زاحم: سنة ستّ و مائة.
و عكرمة مولى ابن عبّاس: سنة سبع و مائة. و الحسن البصري و الأعرج: سنة عشر و مائة.
و عطاء بن أبي رباح و عكرمة بن خالد: سنة خمس عشرة و مائة. و قتادة: سنة سبع عشرة و مائة. و ابن عامر: سنة ثماني عشرة و مائة. و ابن كثير: سنة عشرين و مائة. و عاصم: سنة سبع و عشرين و مائة. و أبو جعفر: سنة ثلاثين و مائة. و الأعمش: سنة ثمان و أربعين و مائة.
و أبو عمرو: سنة أربع و خمسين و مائة. و حمزة: سنة ست و خمسين و مائة. و نافع: سنة تسع و ستين و مائة. و حفص: سنة ثمانين و مائة. و الكسائي: سنة تسع و ثمانين و مائة. و شعبة: سنة ثلاث و تسعين و مائة. و ورش: سنة سبع و تسعين و مائة. و اليزيدي و ابن ذكوان: سنة اثنتين و مائتين. و يعقوب: سنة خمس و مائتين. و قالون و خلّاد: سنة عشرين و مائتين. و خلف: سنة تسع و عشرين و مائتين. و رويس: سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين.
و هشام: سنة خمس و أربعين و مائتين. و الدّوري: سنة ست و أربعين و مائتين. و البزّي: سنة خمسين و مائتين. و السّوسي: سنة إحدى و ستين و مائتين. و قنبل: سنة إحدى و تسعين و مائتين. و ابن جرير: سنة عشر و ثلاثمائة. و ابن مجاهد: سنة أربع و عشرين و ثلاثمائة.
ص: 177
روى البيهقي في كتاب «البعث و النشور» من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم في قوله تعالى: وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ [ (39) الزمر: 68] قال: «فكان ممّن استثنى اللّه تعالى ثلاثة: جبريل، و ميكائيل، و ملك الموت فيقول اللّه تعالى و هو أعلم: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: بقي وجهك الكريم و عبدك جبريل و ميكائيل و ملك الموت- فيقول: توفّ نفس ميكائيل.
و في رواية عن الطّبراني: فيقع كالطّود العظيم، ثم يقول و هو أعلم يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: بقي وجهك الباقي الكريم و عبدك جبريل و ملك الموت فيقول: توفّ نفس جبريل؛ ثمّ يقول و هو أعلم: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: بقي وجهك الكريم و عبدك ملك الموت و هو ميّت فيقول: مت فيموت ثمّ ينادي عزّ و جل: أنا بدأت الخلق ثمّ أعيدهم».
قال مؤلّفه رحمه اللّه تعالى: و فرغت من تأليفه بعون اللّه تعالى يوم الثّلاثاء سابع رجب الفرد سنة اثنتين و سبعين و ثمانمائة، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، و صلى اللّه على سيّدنا و مولانا محمّد و على آله و صحبه و سلّم و رضي اللّه عن أصحاب رسول اللّه أجمعين.
في عاشر شهر شوّال سنة ستّ عشرة و مائة و ألف و حسبنا اللّه وحده.
ص: 178
الصورة
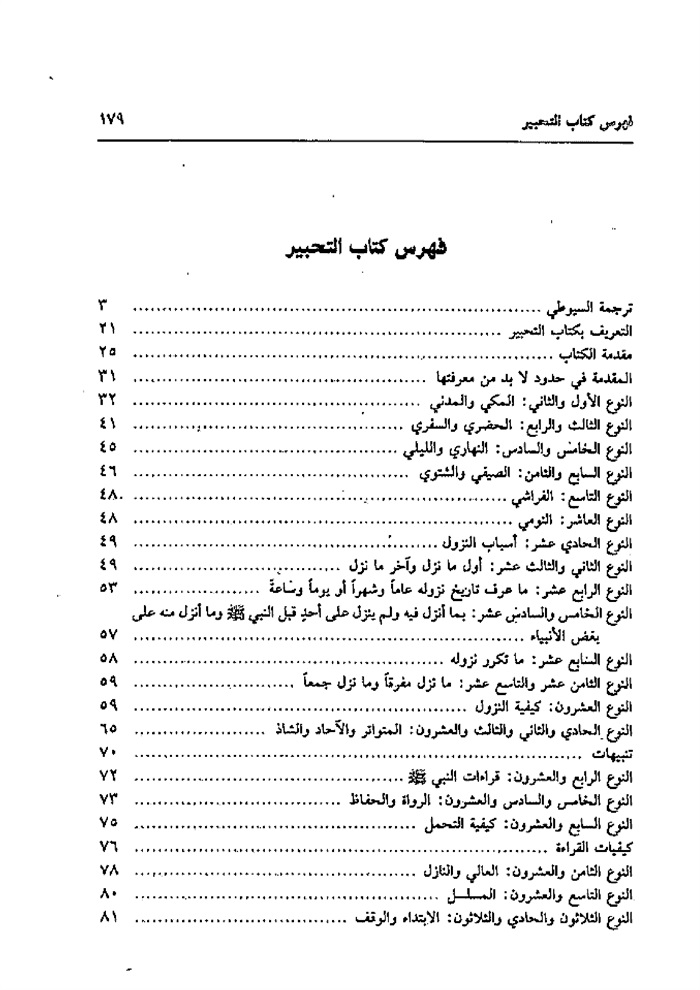
ص: 179
الصورة
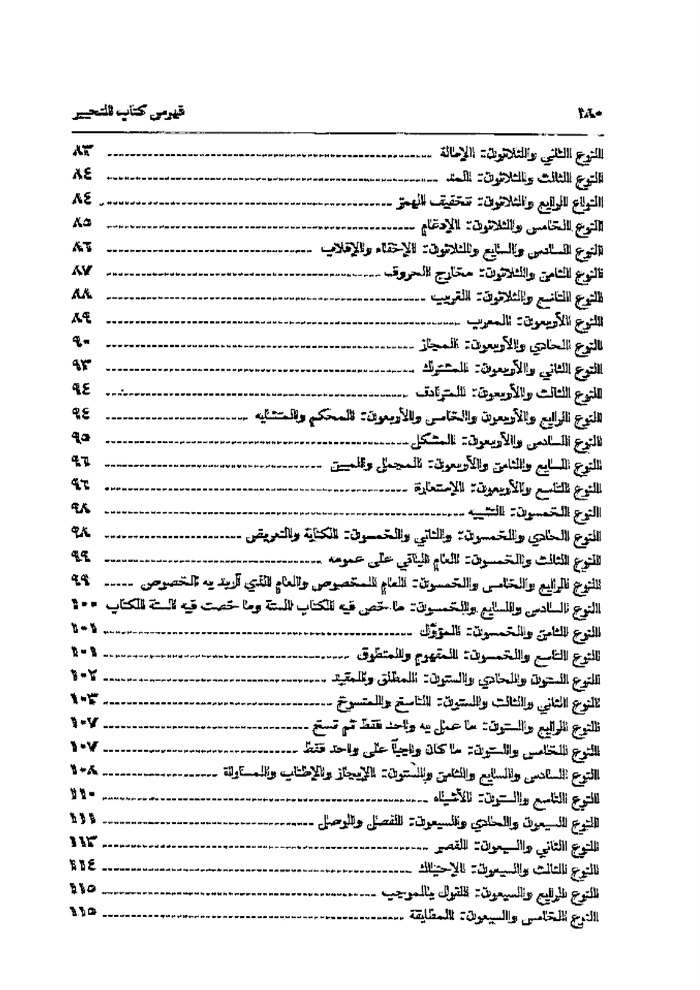
ص: 180
الصورة
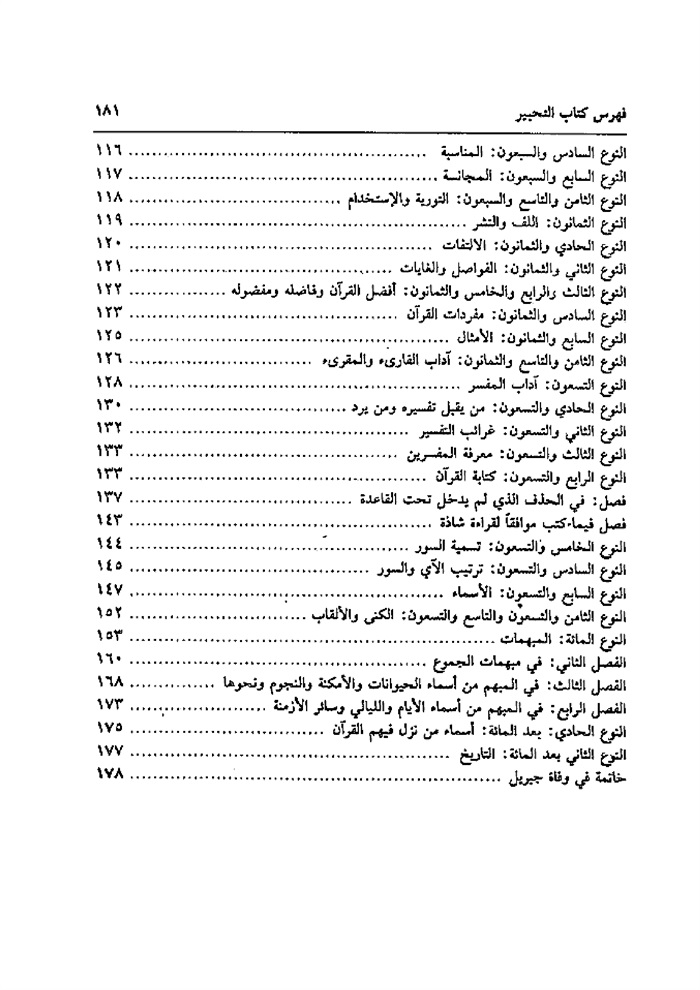
ص: 181