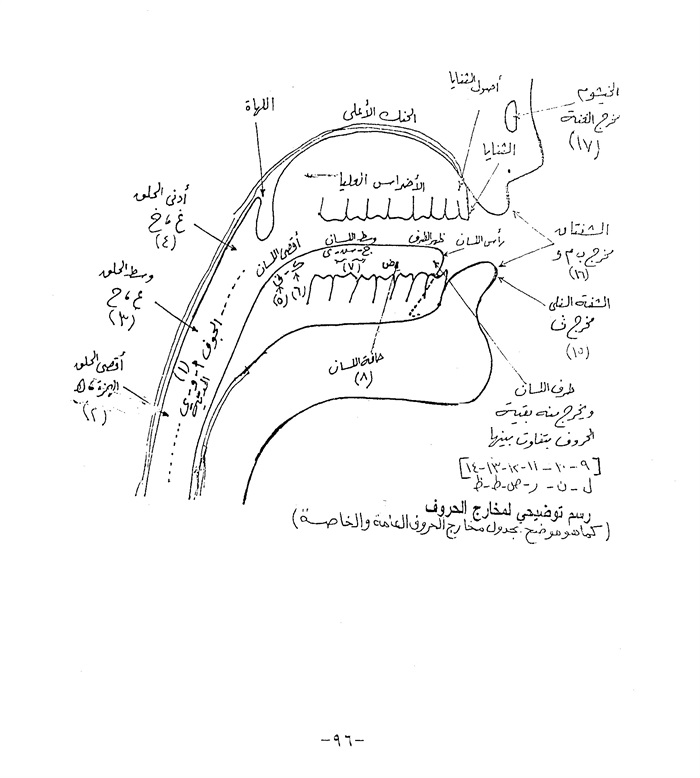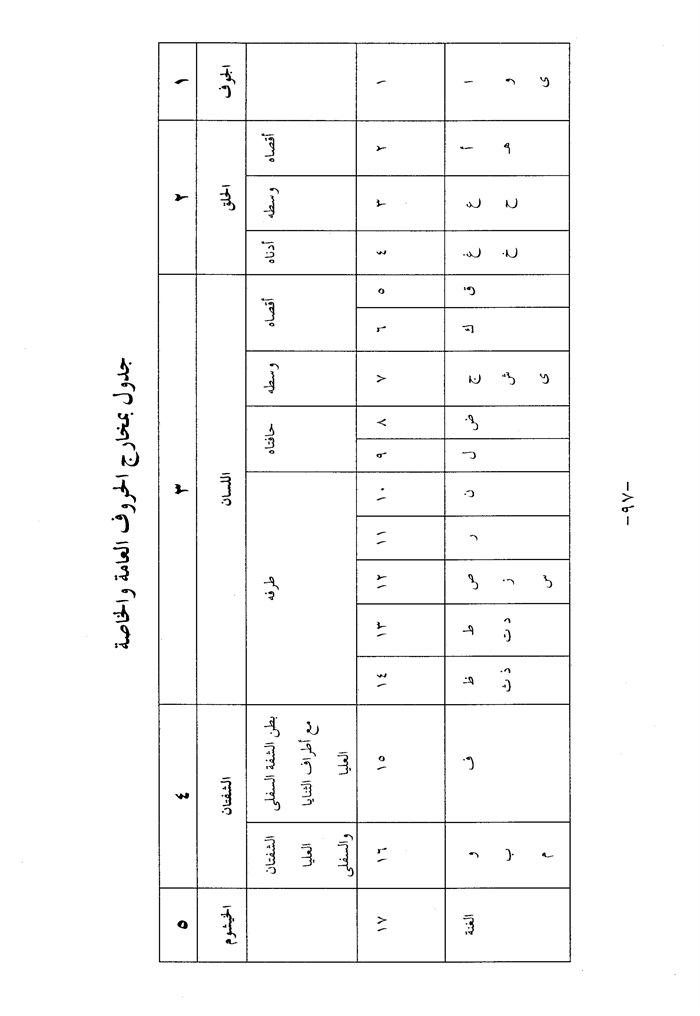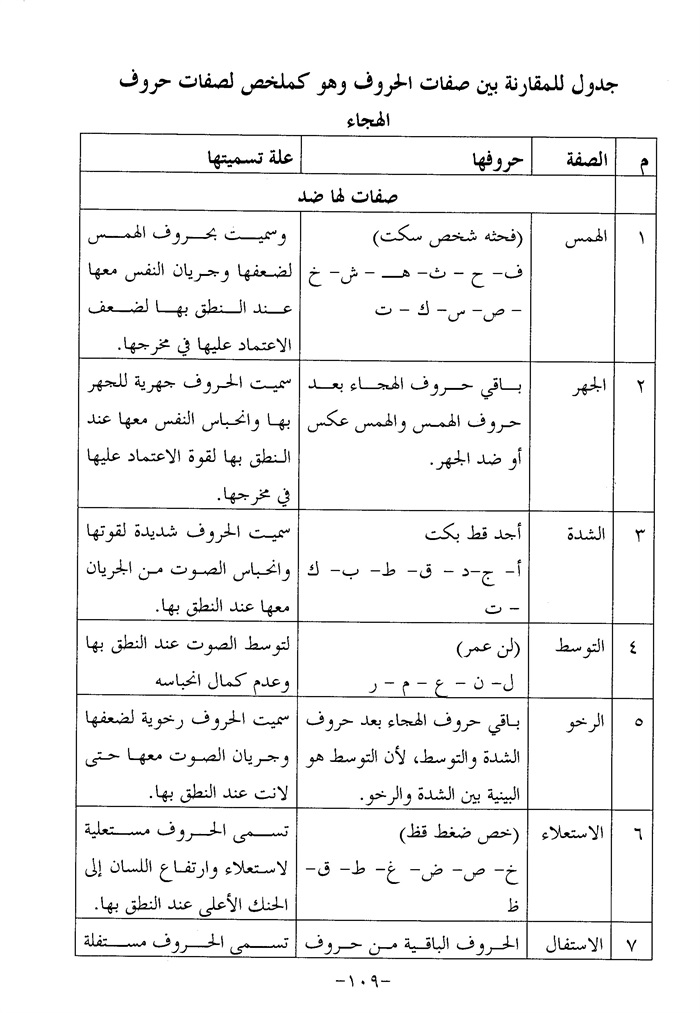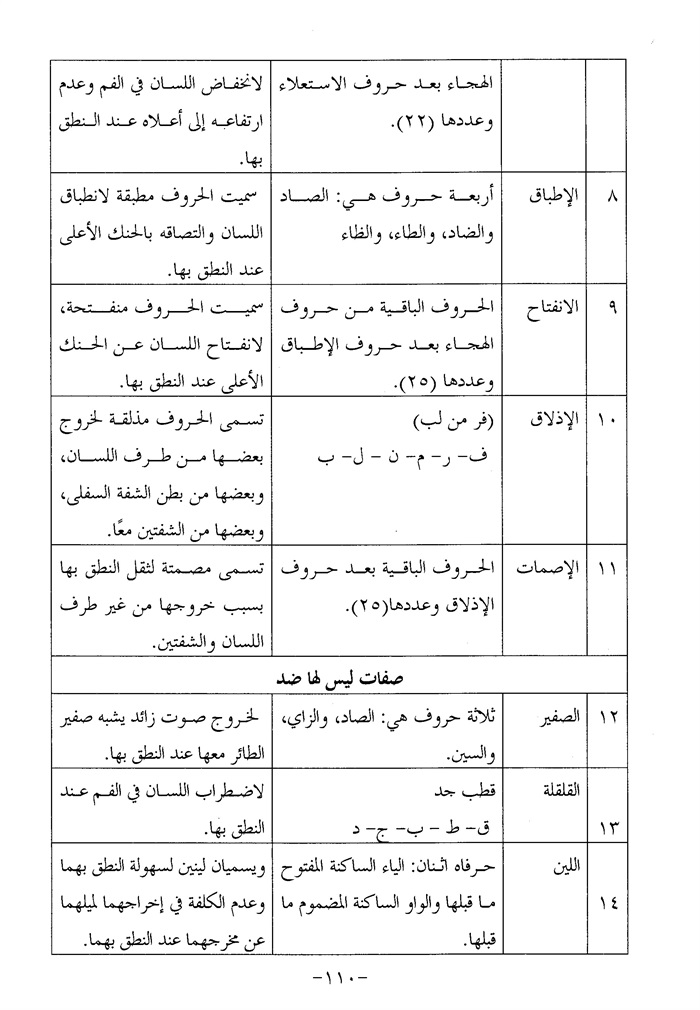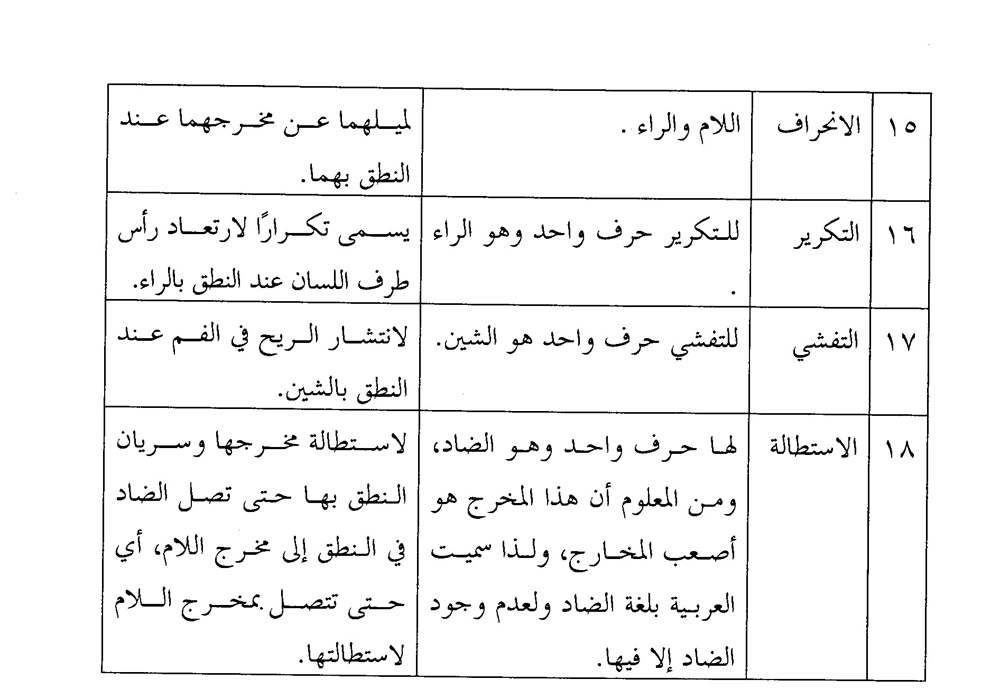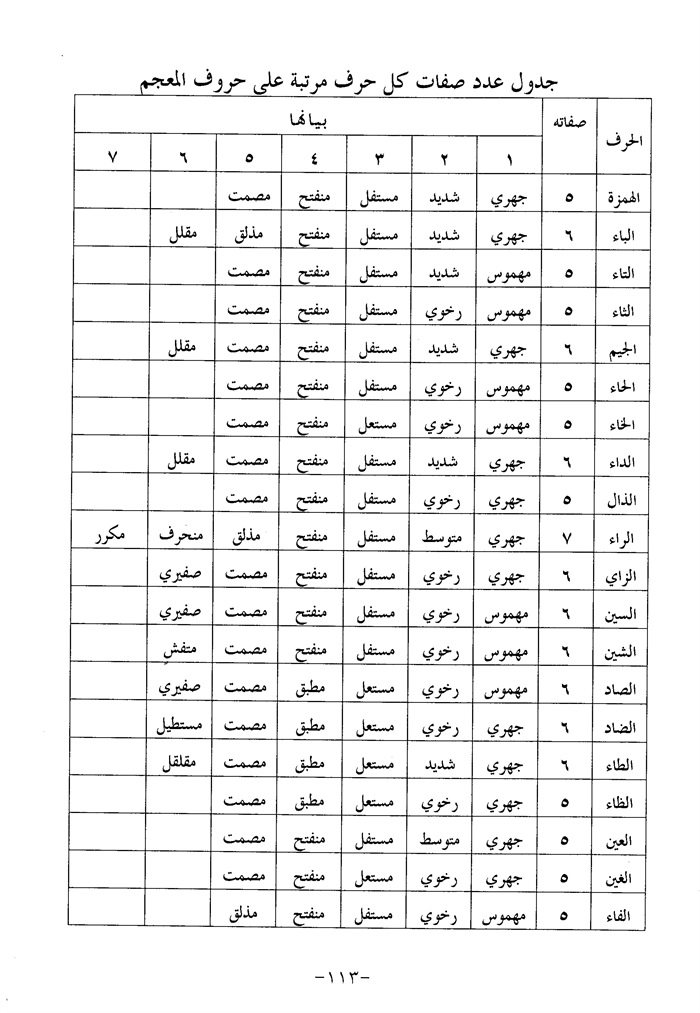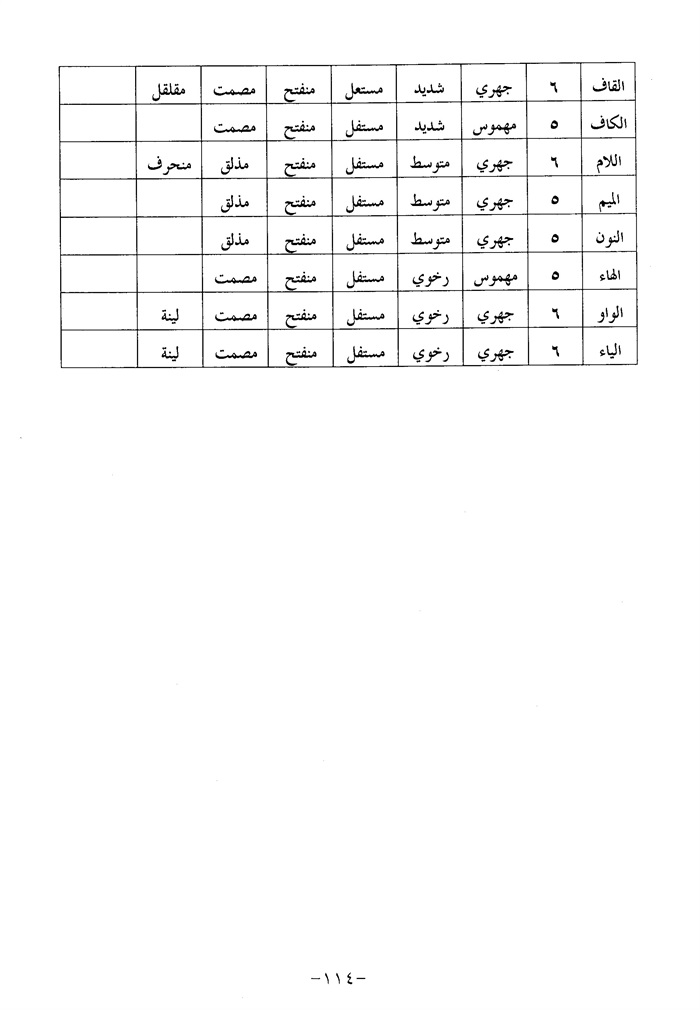التجديد في الإتقان و التجويد
هوية الکتاب
اسم الكتاب: التجديد في الإتقان و التجويد
كاتب: احمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان
موضوع: تجويد / قرائت
تاريخ وفاة المؤلف: معاصر
لسان: العربية
عدد المجلدات: 1
الناشر: دار الكتب العلمية
مكان النشر: بيروت
سنة الطباعة: 1424 / 2003
نشرت: اوّل
ص: 1
اشارة
التجديد في الإتقان و التجويد
كتاب مشتمل على شتى فنون قواعد الأداء
تأليف
أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان عضو نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم
بجمهورية مصر العربية
ویلیه
الكواكب الدرية
في
نزول القرآن على سبعة أحرف
تأليف
محمد بن علی بن خلف الحسيني المالكي الأزهري
المعروف بالحداد
المتوفى سنة ١٣٥٧ه_
منشورات
محمد علي بیضوی
لنشر كتب السنة والجماعة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
ص: 2
التجديد فى الاتقان و التجويد
ص: 3
[التجديد فى الاتقان و التجويد]
المقدمة
المقدمة
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إن الحمد للّه نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: 102].
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء: 1].
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد .. فإن أصدق الحديث كتاب اللّه- تعالى-، و خير الهدي هدي محمد صلى اللّه عليه و سلم، و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك:
رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [البقرة: 127].
رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ [البقرة: 201].
رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ [البقرة: 250].
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ [إبراهيم: 41].
رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ* رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [الممتحنة: 4، 5].
ص: 5
يا رب: أدعوك و أنا العبد الذليل، و أنت الرب العزيز، يا رب أسألك من فضلك و رحمتك لي و لكل المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى و التقى و العفاف و الغنى. اللهم ألهمنا رشدنا، و أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك و نحن نعلم و نستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، و نور أبصارنا، و جلاء أحزاننا، و ذهاب همومنا و غمومنا، اللهم ذكرنا منه ما أنسينا، و علمنا منه ما جهلنا، و ارزقنا حق تلاوته آناء الليل و أطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، و اجعله سابقا لنا إلى رضوانك و جنتك، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم زينا بزينة القرآن، و أكرمنا بكرامة القرآن و شرفنا بشرافة القرآن، و ألبسنا بخلعة القرآن، و أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، و عافنا من كل بلاء الدنيا و عذاب الآخرة بحرمة القرآن، و ارحم جميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا رحمن، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، و في القبر مؤنسا، و في القيامة شفيعا، و على الصراط نورا، و إلى الجنة رفيقا، و من النار سترا و حجابا و إلى الخيرات كلها دليلا و إماما بفضلك و جودك و كرمك يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله و آجله ما علمنا منه و ما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك و نبيك محمد صلى اللّه عليه و سلم، و نعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك و نبيك محمد صلى اللّه عليه و سلم، اللهم إنا نسألك الجنة و ما قرب إليها من قول و عمل، و نعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول و عمل، و نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ... آمين.
و صلى اللّه على محمد و آله و صحبه و سلم، و الحمد للّه رب العالمين.
ص: 6
قال اللّه تعالى:
وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً [الإسراء: 82].
قال ابن كثير- رحمه اللّه تعالى- في تفسيره العظيم: «يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى اللّه عليه و سلم، إنه شفاء و رحمة للمؤمنين، أي:
يذهب ما في القلوب من أمراض من شك و نفاق، و شرك و زيغ و ميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، و هو أيضا رحمة، يحصل فيها الإيمان و الحكمة و طلب الخير و الرغبة فيه، و ليس هذا إلا لمن آمن به و صدقه و اتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه و رحمة، و أما الكافر الظالم نفسه بذلك، فلا يزيده سماع القرآن إلا بعدا و كفرا، و الآفة من الكافر لا من القرآن، كقوله تعالى:
قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفاءٌ وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ [فصلت: 44].
قال قتادة: إذا سمعه المؤمن انتفع به و حفظه و وعاه وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً أي لا ينتفع به و لا يحفظه و لا يعيه، فإن اللّه جعل هذا القرآن شفاء و رحمة للمؤمنين.
و بعد ..
فما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة- و قد أخذت المقدسات و انتهكت الأعراض- أن نعود إلى ديننا، متمسكين بقرآننا، و سنة نبينا؛ ليعود لنا المجد السالف، و العزة المفقودة.
ما أحوجنا إلى شيوخ و شباب، و نساء و أطفال يتلون آيات اللّه في الليل و النهار، يطوفون حوله بقلوبهم، و لا يطوفون حول «أبو اليزيد و الشبلي»، يعطون اليتيم و لا يأخذون منه، يحيون السيرة العطرة لا الخرافات.
ما أحوجنا إلى أن نحمل القرآن في قلوبنا و السلاح في أيدينا لنحرر مقدساتنا و أوطاننا من أعداء الإسلام و القرآن.
ص: 7
ما أحوجنا إلى جيل جديد يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة، و يأخذه جملة بشرائعه و أحكامه، و حلاله و حرامه كما أخذه المسلمون الأولون فكانوا سادة الدنيا و أبطال التاريخ.
و من المعلوم أن علم التجويد من أشرف العلوم و أجلها، و ذلك لتعلقه بكتاب رب العالمين، و الذكر الحكيم.
و لا يؤخذ هذا العلم عن الكتب و الدفاتر و الرسائل، فلا بد من تلقي كل علم عن أهله، و بخاصة علم التجويد، فابحث يا أخي عن أهل القرآن و اعرض عليهم قراءتك و استمع لإرشاداتهم و تلقينهم، كي تقرأ القرآن كما أقرأه جبريل للرسول الأعظم صلى اللّه عليه و سلم، و كما أقرأه الرسول لصحابته الكرام، و كما تناقله حملته جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا محفوظا و سيبقى كذلك إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها مصداقا لقوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ.
و لست أدعي في عملي هذا الكمال، فالكمال من صفات اللّه- تعالى-، و لكن حسبي أني خطوت خطوة، و مهدت السبيل لطالب العلم ليتصل بهذا العلم، و ليتعمق في دراسته، و يتصل بالقراءات و حلقات العلم.
و يحتوي هذا الكتاب على مباحث عدة علاقتها بالتجويد قوية و هي سلسلة مترابطة مرضية و سهلة المأخذ تعالج قضايا مترابطة مثل وجوب علم التجويد، و مناقشة المخارج و الصفات و ترتيبها ترتيبا جديدا، و تقديم بعض الجداول و الرسومات التي تساعد على فهم هذه الأبواب، كما أنه تناول نبذة عن جمع القرآن و موضوعات أخرى، و قد ألحقت بهذا الكتاب بحثا عما ورد في إنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف من الأحاديث النبوية و الأخبار المأثورة في بيان احتمال رسم المصاحف العثمانية للقراءات المشهورة و نص الأئمة الثقات في ضابط المتواتر من القراءات، و ما يناسب ذلك، و ذلك لتعلقه
ص: 8
بمادة الكتاب العلمية و تتميما للفائدة، و هو تأليف الإمام العالم الشيخ محمد الشهير بالحدّاد.
أرجو اللّه- تعالى- أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، و أن ينفع بهذه الرسالة المبسطة عباده الصالحين و أن تكون لي ذخرا يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم.
و صلى اللّه على نبي الرحمة و إمام المؤمنين و الحمد للّه رب العالمين.
أبو إسلام/ أحمد محمود عبد السميع أبو سنادة مصر- المنيا- أبو قرقاص- بني موسى 27 محرم 1423 ه- 10 أبريل 2002 م
ص: 9
وجوب علم التجويد، و أهمية التلقي من أفواه المشايخ
أ- وجوب علم التجويد:
اشارة
- لقد اهتمت الأمة الإسلامية بعلم التجويد (1) اهتماما بالغا، فقام علماء السلف رضي اللّه عنهم بخدمته و رعايته سواء بالتحقيق و التأليف أو القراءة و الإقراء.
و بذلك ظل القرآن الكريم محفوظا في الصدور مرتلا مجودا تحقيقا لوعد اللّه- سبحانه و تعالى- بحفظه حيث قال: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (2).
و الواقع أن من حق القرآن علينا نحن المسلمين أن نجيد تلاوته و ترتيله حتى يكون عونا لنا على تدبره، و تفهم معانيه، و لا يتأتى ذلك إلا بالاهتمام بدراسة علم التجويد و معرفة أحكامه و تطبيقها إما بالاستماع إلى قارئ مجيد، أو القراءة على شيخ حافظ متقن مدقق.
و ينقسم التجويد إلى قسمين:
اشارة
1- تجويد عملي.
2- تجويد علمي.
القسم الأول: التجويد العملي، أي: التطبيقي:
و المقصود به تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة كما أنزلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم باعتباره مبلغا عن اللّه- عز و جل-، حيث كان يعلم أصحابه القرآن الكريم فيقرأ عليهم و يستمع إليهم.
و حكم تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة أمر واجب وجوبا عينيا على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم من مسلم و مسلمة، و الدليل على
ص: 10
1- من كتاب غاية المريد ص 35.
2- سورة الحجر (9).
وجوبه،- أي: الدليل على وجوب تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة- قد جاء به القرآن الكريم و السنة، و إجماع الأمة. أما دليله من القرآن: فقوله- تعالى- في سورة المزمل: وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. كما أثنى اللّه- تبارك و تعالى- على طائفة من خلقه شرفهم بحفظ كتابه، و تلاوته حق التلاوة فقال تعالى: الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ (1) و من حق التلاوة حسن الأداء و جودة القراءة، و قال الشوكاني في فتح القدير: أي يقرءونه حتى قراءته و لا يحرفونه و لا يبدلونه.
و مما لا شك فيه أنه يفهم من الآية ذم الذين لا يحسنون تلاوة القرآن الكريم، و لا يراعون أحكام التجويد عند تلاوته.
و أما دليله من السنة: فمنها ما ثبت عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة- رضي اللّه عنها- عن قراءة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و صلاته؟ قالت: ما لكم و صلاته؟ ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذه رواية النسائي، و رواه الترمذي بلفظ آخر و قال فيه: حديث حسن صحيح.
و في هذا الحديث دليل على أن تحسين القراءة و تجويدها هي سنة النبي صلى اللّه عليه و سلم.
و منها ما ثبت من حديث موسى بن يزيد الكندي رضي الله عنه قال: كان ابن مسعود رضي اللّه عنه يقرئ رجلا فقال الرجل: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ مرسلة، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، فقال الرجل:
و كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ و مدّها.
و هكذا أنكر ابن مسعود رضي اللّه عنه على الرجل أن يقرأ كلمة (الفقراء) بالقصر لأن النبي صلى اللّه عليه و سلم أقرأه إياها بالمد، فدل ذلك على وجوب تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة و هي الموافقة لأحكام التجويد.).
ص: 11
1- سورة البقرة (121).
و الواقع أن الناس كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن الكريم و إقامة حدوده فهم متعبدون أيضا بتصحيح ألفاظه، و تجويد حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصل سندهم بالنبي صلى اللّه عليه و سلم.
و هذه الصفة لا يمكن أن تؤخذ من المصحف و لا من الكتب، و إنما تؤخذ بالتلقي عن العلماء المتخصصين في ذلك؛ لأن هناك بعض الأحكام التي لا يمكن إتقانها إلا بالتلقي و المشافهة مثل: الروم و الإشمام و التسهيل ... و غير ذلك من الأحكام الدقيقة.
و معرفة أحكام التجويد لها فضل كبير في مساعدة قارئ القرآن الكريم على عدم الإخلال بمباني الكلمات القرآنية و معانيها. و بلوغ نهاية الإتقان هو رياضة اللسان على الأداء باللفظ الصحيح المتلقّى عن فم المحسن المجيد للقراءة.
أما دليله من الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب تلاوة القرآن الكريم بالتجويد من زمن النبي صلى اللّه عليه و سلم إلى زماننا هذا، و لم يختلف فيه منهم أحد، فلا يجوز لأي قارئ أن يقرأ القرآن بغير تجويد، و إلا كان من الذين شملهم الوعيد الشديد في قوله- تعالى-: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً (1).
و إلى ضرورة العمل بالتجويد يشير الإمام المحقق ابن الجزري بقوله:
و الأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
لأنه به الإله أنزلا و هكذا منه إلينا وصلا
و هو أيضا حلية التلاوة و زينة الأداء و القراءة
فقد جعله واجبا شرعيا يأثم الإنسان بتركه و به قال أكثر العلماء و الفقهاء، ذلك لأن القرآن نزل مجودا و قرأه الرسول صلى اللّه عليه و سلم على جبريل كذلك،).
ص: 12
1- سورة النساء (115).
و أقرأه الصحابة فهو سنّة نبوية.
القسم الثاني: التجويد العلمي (النظري):
القسم الثاني: التجويد العلمي (النظري):
و المقصود به: معرفة قواعده و أحكامه العلمية التي نحن بصدد الكلام عليها.
و حكم تعلم التجويد العلمي فالناس أمامه فريقان:
الفريق الأول: عامة الناس .. و تعلمه بالنسبة لهم مندوب، و ليس بواجب.
الفريق الثاني: خاصة الناس .. و هم الذين يتصدون للقراءة أو الإقراء و تعلمه بالنسبة لهم واجب وجوبا عينيا؛ حتى يكونوا قدوة لغيرهم من العامة في تلاوة كتاب اللّه حق التلاوة.
و إن لم يكن هناك جماعة من الناس يقومون بتعليم الناس القرآن و الأحكام أثم الجميع.
ب- أهمية التلقي من أفواه المشايخ (المشافهة):
اشارة
اشترط علماء و كبار فن التجويد في من يريد أن يأخذ علم التجويد أن لا بد له من التلقي من أفواه المشايخ، فالتلقي شرط لازم في هذا الفن، لأن التلقي يعتبر امتدادا لسلسلة النور التي نزل بها سفير الوحي جبريل- عليه السلام- من اللوح المحفوظ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فتلقى الرسول من جبريل بالمشافهة- أي: ينطق أمين الوحي و يسمع الحبيب صلى اللّه عليه و سلم و لا يحرك به لسانه حتى ينصرف- جبريل عليه السلام-، و هكذا أعطى الرسول صلى اللّه عليه و سلم القرآن الكريم للصحابة أيضا مشافهة، ينطق النبي صلى اللّه عليه و سلم و يستمع الصحابة ثم يرددون و يحفظون، و هكذا منهم إلينا وصل القرآن الكريم، كما أنزل من السماء، و لأن هناك كلمات في القرآن يختلف رسمها عن نطقها نحو: حم عسق، و كهيعص، و لأن هناك أحكاما لا تؤخذ من كتاب بل تؤخذ من أفواه المشايخ: كالروم و الإشمام و الفتح و الإمالة و التقليل، و لأن المشافهة فيها الاقتداء بسنة النبي صلى اللّه عليه و سلم و تحقيقا لصحة الإسناد.
ص: 13
فائدة:
لعلم التجويد فوائد جمة منها: حسن الأداء و جودة القراءة الموصلان إلى رضا اللّه تعالى لتحصل السعادة في الدارين: الدنيا، و الآخرة، و منها البعد عن اللحن، و منها حفظ القرآن كما أنزل و هناك فوائد لا يعلمها إلا من هذا كلامه و هو اللّه سبحانه.
مسائل ظن البعض أنها نوع واحد
اشارة
1- ظن كثير من الدارسين و المتلقين للأحكام أن الإدغام ينقسم إلى نوعين فقط هما: إدغام بغنة، و إدغام بغير غنة، و لكن بالبحث و الدراسة و النظر في بطون الكتب اتضح أن هناك أنواعا كثيرة، منها:
(1) نوع من الإدغام يتعلق بأحكام النون الساكنة و التنوين، و ذلك إذا أتى بعد النون الساكنة و التنوين حروف (يرملون) و ينقسم إلى:
- إدغام بغنة نحو: (من يقول)، (يومئذ يصدر)، (من ولى)، (رحيم ودود)، (من ماء)، (صراطا مستقيما)، و يسمى إدغاما ناقصا.
- إدغام بغير غنة نحو: (لئن لم ينته)، (هدى للمتقين)، (من ربهم)، (ثمرة رزقا)، و يسمى إدغاما كاملا.
و منها:
- إدغام اللام الشمسية، و تسمى اللام شمسية إذا كان بعدها أي حرف من الحروف الآتية:
الطاء، و الثاء، و الصاد، و الراء، و التاء، و الضاد، و الذال، و النون، و الدال، و السين، و الظاء، و الزاي، و الشين، و اللام، و عدد هذه الأحرف أربعة عشر حرفا تجمع في أوائل كلم هذا البيت:
طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم
و حكم هذه اللام الإدغام، و هذا ما اتفق عليه علماء هذا الفن، و تسمى لام (أل).
ص: 14
- إدغام المتجانسين الصغير، و ذلك إذا كانت الحروف المتجانسة هي (ب- ت- ث- د- ذ) فقط، و المتجانسان الصغير إذا كان الحرف الأول ساكنا و الثاني متحركا.
- إدغام المثلين الصغير فقط، و يشترط أن يكون الحرف الأول ساكنا و الثاني متحركا، و حكمه وجوب الإدغام إلا إذا كان الأول حرف مد أو ها سكت، و أمثلة ذلك:
اضْرِبْ بِعَصاكَ، رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ، وَ قَدْ دَخَلُوا، أَقُلْ لَكُمْ، وَ هُمْ مِنْ، عَنْ نَفْسٍ، يُدْرِكْكُمُ، يُوَجِّهْهُ.
- إدغام المتقاربين الصغير عند البعض، و الكبير عند السوسي فقط.
- أمثلة لإدغام حروف الهجاء نفسها:
* إدغام الباء في الباء: نحو قوله تعالى: لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ (1). و القراءة لأبي عمرو.
* إدغام التاء في التاء: نحو قوله تعالى: الشَّوْكَةِ تَكُونُ (2) أدغم أبو عمرو التاء المثقلة من هاء (الشوكة) في تاء (تكون).
* إدغام الثاء في الثاء: أدغم أبو عمرو الثاء في مثلها في نحو قوله تعالى:
ثالِثُ ثَلاثَةٍ (3).
* إدغام الجيم في الجيم: ذكر سيبويه أن الجيم لا تدغم إلا في الشين فقط (4).
ص: 15
1- سورة البقرة (20)، و هي قراءة السدس أيضا، انظر معاني الفراء 1/ 19، و الكشف عن وجوه القراءات لمكي 1/ 134، و النشر لابن الجزري 1/ 300، و شرح ابن يعيش 10/ 147.
2- سورة الأنفال (7).
3- سورة المائدة (73)، انظر الكتاب 3/ 559، و المقتضب 2/ 181، و النشر 1/ 280.
4- . 4/ 452 سيبويه، كقولك: ابعج شبثا، الإدغام و البيان حسنان لأنهما من مخرج واحد، و هما من حروف وسط اللسان.
* إدغام الحاء في الحاء: ذكر أبو عمرو إدغام الحاء في مثلها في نحو قول اللّه تعالى: عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى (1).
* إدغام الخاء في الخاء: من المعلوم أن الخاء و الغين، و هما من مخرج واحد، و كل واحدة منهما لا تدغم إلا في مثلها أو في الأخرى، و قد ذكر ذلك الإمام السيرافي و قال: و لم أر أحدا ذكر إدغام واحدة منهما في مثلها و في الأخرى في القرآن إلا في قوله تعالى: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ (2) فإن أبا عمرو أدغمه فيه.
* إدغام الدال في الدال: أدغم أبو عمرو الدال في عشرة أحرف هي:
التاء، و الثاء، و الجيم، و الذال، و الزاي، و السين، و الشين، و الصاد، و الضاد، و الظاء، و من الممكن أن تدغم الدال في الذال في مثل قوله تعالى: الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ (3).
* إدغام الذال في الذال: أدغم أبو عمرو الذال في مثلها في مثل قول اللّه تعالى: إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً (4).
* إدغام الراء في الراء: تدغم الراء في مثلها، و روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يدغم الراء في مثلها، ساكنا كان ما قبلها، أو متحركا، و الساكن ما قبلها نحو قول اللّه تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ (5).).
ص: 16
1- سورة البقرة (235) الآية (.. و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)
2- سورة آل عمران (85) (و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) انظر إدغام القراء ص 29.
3- سورة البروج (14، 15).
4- سورة الأنبياء، (87).
5- سورة البقرة (185).
* إدغام الزاي في الزاي: قال الإمام السيرافي في إدغام القراء: و أما الزاي فما أعلمها أدغمت في شي ء من حروف القرآن، و قد أدغم فيها من الحروف ما يذكر في القرآن.
* إدغام السين في السين: أدغم أبو عمرو السين في مثلها في نحو قوله تعالى: وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً (1)، و هذا جمع بين ساكنين و ليس قبله حرف لين، و أدغمها في جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً (2).
* إدغام الشين في الشين: أدغم أبو عمرو الشين في مثلها في نحو قوله تعالى: إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (3).
* إدغام الصاد في الصاد: لا تدغم الصاد في مثلها و لكنها تدغم في غيرها.
* إدغام الضاد في الضاد: و لم تدغم في شي ء إلا ما ذكر أبو بكر بن مجاهد: أن أبا شعيب السوسي (4)، روى عن اليزيدي عن أبي عمرو، أنه كان يدغم الضاد في الشين في قوله تعالى: لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ.
* إدغام الطاء في مثلها و الظاء في مثلها: لا يوجد في إدغام الطاء في مثلها، و لا إدغام الظاء في مثلها شي ء و لكنهما يدغمان في غيرهما.
* إدغام العين في العين: لا تدغم العين إلا في مثلها فقط، و ذلك في قول اللّه تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، و لا يوجد شي ء عن الغين إلا في غيرها.
ص: 17
1- سورة نوح (16)، انظر النشر 1/ 280.
2- سورة الحج (25)، انظر النشر 1/ 280.
3- لأن الشين فضل استطالة في التفشي و زيادة صوت السين انظر ابن يعيش (10/ 139).
4- هو صالح بن زياد السوسي، أبو شعيب، مقرئ ضابط للقراءات ثقة (ت 261 ه)، ترجمته في غاية النهاية 1/ 332.
* إدغام الفاء في الفاء: لا تدغم الفاء إلا في مثلها مثل العين، لأن في الفاء تفشيا، و لأنها أمكن موضعا، و تدغم في مثلها في قوله تعالى: وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ.
* إدغام القاف في القاف: تدغم القاف في مثلها في نحو قوله تعالى:
أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ بسورة يونس.
* إدغام الكاف في الكاف: تدغم في مثلها في نحو قول اللّه تعالى:
كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً بسورة طه.
* إدغام اللام في اللام: أدغم أبو عمر اللام في اللام في نحو قول اللّه تعالى: وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي بسورة الأحزاب.
* إدغام الميم في الميم: أدغم أبو عمرو الميم في الميم في نحو قول اللّه تعالى: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ بسورة البقرة.
* إدغام النون في النون: أدغم أبو عمرو النون في النون في نحو قول اللّه تعالى: تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ.
إدغام الواو في الواو: أدغم الواو في الواو أبو عمرو، فقد ذكر أبو بكر بن مجاهد أن أبا عمرو كان يدغمها في مثلها كقوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ.
* إدغام الهاء في الهاء: لا يدغم أبو عمرو الهاء إلا في مثلها، و ذلك في نحو قوله تعالى: فِيهِ هُدىً في سورة البقرة.
* إدغام الياء في الياء: أدغم أبو عمرو الياء في مثلها إذا سكن ما قبلها أو تحرك كقوله تعالى: وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ (1)، و قوله تعالى: فَهِيَ يَوْمَئِذٍ).
ص: 18
1- سورة هود (66)، انظر النشر 1/ 284، و تحبير التيسير، قال النحاس: الذي يرويه النحويون- مثل سيبويه و من قاربه عن أبي عمرو في مثل هذا الإخفاء، فأما الإدغام فلا يجوز- لأنه يلتقي ساكنان و لا يجوز كسر الزاي، انظر تفسير القرطبي (9/ 61).
واهِيَةٌ، و قوله تعالى: وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ.
2- ظن الكثير أيضا أن للإظهار نوع واحد، و لكن بالبحث و الدراسة وجد أن له أنواعا كثيرة، نذكر منها تسعة أنواع هي:
- الإظهار الحلقي: و هو متعلق بالنون الساكنة و التنوين، و حروفه: (ء- ه- ع- ح- غ- خ) تجمع هذه الحروف في أوائل كلم هذا البيت (1):
همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء
- الإظهار الشفوي: و هو متعلق بالميم الساكنة، و حروفه: كل الحروف الهجائية ما عدا: (الباء- و الميم) و أشده مع: (الواو- و الفاء).
- الإظهار المطلق: يأتي هذا النوع في الكلمات الآتية فقط: (دنيا- بنيان- صنوان- قنوان).
- إظهار لام الاسم: و هذا النوع يأتي في مثل الكلمات الآتية:
(ألسنتكم- ألوانكم).
- إظهار لام الفعل: و هذا النوع فيه إظهار لام الفعل، و هنا يستوي فيه الفعل الماضي و المضارع و الأمر، فكل فعل وردت فيه لام الفعل فحكمها الإظهار و ذلك نحو: (قل- قلنا- يلتقطه).
قال الجمزوري:
و أظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم و قلنا و التقى
- إظهار لام الحرف: و هذا النوع يأتي في (هل) و (بل) في القرآن الكريم.
- إظهار اللام القمرية: و اللام القمرية يأتي بعدها من حروف الهجاء أربعة عشر حرفا تسمى حروف اللام القمرية و تجمع في: «ابغ حجك و خف عقيمه»، و أمثلتها مرتبة كالآتي:-.
ص: 19
1- هذا البيت من ذكر في متن تحفة الأطفال و الغلمان، و هو من تأليف سليمان الجمزوري- رحمه اللّه تعالى-.
(الأنهار- الباسط- الغني- الحليم- الجبار- الكبير- الولي- الهادي)، و كل هذه الكلمات من القرآن الكريم.
- إظهار لام الأمر: و ذلك في نحو قوله تعالى: (فَلْيَنْظُرْ- ثُمَّ لْيَقْضُوا- وَ لْيُوفُوا).
- إظهار المتباعدين و المتقاربين، و المثلين و المتجانسين من الحروف الهجائية، و كل هذه الأنواع يجب فيه الإظهار عند حفص.
ص: 20
موجز عن تاريخ التجويد و القراءات
تاريخ التأليف في هذا الفن:
موجز عن تاريخ التجويد و القراءات (1)
إن أول من وضع قواعد التجويد العلمية أئمة القراءة و اللغة في ابتداء عصر التأليف، و قيل: إن الذي وضعها هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، و قال بعضهم: أبو الأسود الدؤلي، و قيل أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام، و ذلك بعد ما كثرت الفتوحات الإسلامية، و انضوى تحت راية الإسلام كثير من الأعاجم، و اختلط اللسان الأعجمي باللسان العربي، و فشا اللحن على الألسنة، فخشي ولاة المسلمين أن يفضي ذلك إلى التحريف في كتاب اللّه، فعملوا على تلافي ذلك، و إزالة أسبابه، و أحدثوا من الوسائل ما يكفل صيانة كتاب اللّه- عز و جل- من اللحن، فأحدثوا فيه النقط و الشكل بعد أن كان المصحف العثماني خاليا منهما، ثم وضعوا قواعد التجويد حتى يلتزم كل قارئ بها عند ما يتلو شيئا من كتاب اللّه- عز و جل-.
و لقد كانت بداية النظم في علم التجويد قصيدة أبي مزاحم الخاقاني المنوفي سنة 325 ه و ذلك في أواخر القرن الثالث الهجري و هي تعتبر أقدم نص نظم في علم التجويد.
و منها نظم ابن الجزري المسمى بمتن الجزرية، و قصيدة سليمان الجمزوري المسماة بتحفة الأطفال، و قصيدة الشيخ الجليل الإمام العالم المقرئ الأديب صدر الشام علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي- رحمه اللّه تعالى-، و تسمى: عمدة المجيد و عدة المستفيد في معرفة التجويد (و هي مخطوطة) (2) تبدأ بقوله:
ص: 21
1- ورد بكتاب غاية المريد في علم التجويد ص 22.
2- انظر مخطوط كتاب عمدة المجيد بمعهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة للسخاوي المتوفى 643 ه.
يا من يروم تلاوة القرآن و يرود شأو أئمة الإتقان
و هناك كثير من القصائد المنظومة و الأقوال المنثورة في فن التجويد.
و أما القراءات فلعل أول من جمع هذا العلم في كتاب هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام و ذلك في القرن الثالث الهجري فقد ألف كتاب (القراءات) الذي قال عنه الحافظ الذهبي: و لأبي عبيد كتاب في القراءات ليس لأحد من الكوفيين مثله، توفي ابن سلام بمكة المكرمة سنة 224 ه.
و قيل: إن أول من جمع القراءات و دونها: أبو عمرو حفص بن عمر الدوري المتوفى سنة 246 ه، و قيل غير ذلك.
و قد اشتهر في القرن الرابع الهجري الحافظ أبو بكر بن مجاهد البغدادي، و هو أول من أفرد السبعة في كتاب، و قد توفي سنة 324 ه.
كما اشتهر في القرن الخامس الهجري الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (1) و له تصانيف كثيرة في هذا الفن، و أهمها كتاب التيسير، و قد توفي ببلاد الأندلس، و من أهم مصنفاته (2):
1- جامع البيان في السبع.
2- كتاب التيسير.
3- كتاب الاقتصاد في السبع.
4- كتاب إيجاز البيان في قراءة ورش.
5- التلخيص في قراءة ورش.
6- المقنع في الرسم.ا.
ص: 22
1- هو الإمام الجليل عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو أبو عمرو المقرئ الأموي مولاهم، الأندلس: القرطبي. الحافظ، المالكي الداني شهرته و قيل كنيته أبو عمرو الداني، ابن الصيرفي قديما، مالكي المذهب، ولد سنة 371 ه و توفي 444 ه.
2- انظر مختصر في مذاهب القراء السبعة من تحقيقنا.
7- كتاب المحتوى في القراءات الشواذ.
8- طبقات القراء.
9- الأرجوزة في أصول الديانة.
10- كتاب الوقف و الابتداء.
11- كتاب العدد.
12- كتاب التمهيد في حرف نافع.
13- كتاب اللامات و الراءات لورش.
14- كتاب الفتن الكائنة.
15- كتاب الهمزتين.
16- كتاب الياءات.
17- كتاب الإمالة لابن العلاء.
18- كتاب الموضوع في الفتح و الإمالة.
19- كتاب التجديد و الإتقان.
أما في القرن السادس الهجري فقد اشتهر الإمام القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي (1) و ألف «حرز الأماني و وجه التهاني» المعروف بالشاطبية و التي لخص فيها كتاب التيسير في القراءات السبع، و هي قصيدة مباركة، و عدد أبياتها 1173 بيتا، و قد نظم أيضا قصيدته الرائية المسماة: عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم الرسم، و قصيدة أخرى تسمى «ناظمة الزهر» في علم عدد الآي، و قصيدة دالية خمسمائة بيت لخص فيها التمهيد لابن عبد البر.
و لقد حكى عنه أصحابه و من كان يجتمع به عجائب و عظموه تعظيماه.
ص: 23
1- هو القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد أبو القاسم و أبو محمد الشاطبي الرعيني الضرير، ولد آخر سنة 538 ه بشاطبة من الأندلس، و قرأ ببلده القراءات و أتقنها على أبي عبد اللّه محمد بن أبي العاص النفري، و توفى سنة 590 ه.
بالغا حتى أنشده الإمام الحافظ أبو شامة الدمشقي- رحمه اللّه- من نظمه قال:
رأيت جماعة فضلاء فازوا برؤية شيخ مصر الشاطبي
و كلهم يعظمه و يثني كتعظيم الصحابة للنبي (1)
ثم توالت بعد ذلك الأئمة الأعلام صارفين أعمارهم في التسابق لخدمة هذا العلم تصنيفا و تحقيقا، حتى قيض اللّه- عز و جل- له إمام المحققين أبا الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، فألف الكثير من كتب القراءات، و له طيبة النشر في القراءات العشر، و قد ولد ابن الجزري- رحمة اللّه تعالى عليه- ليلة السبت الخامس و العشرين من شهر رمضان سنة 751 ه، و توفي سنة 833 ه.
منشأ اختلاف القراءات:
يقول ابن هاشم: إن السبب في اختلاف القراءات السبع و غيرها هو:
أن الجهات التي و جهت إليها المصاحف التي كتبت في عهد الخليفة عثمان كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة و تلقوا عنه القرآن، و كانت المصاحف خالية من النقط و الشكل، فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة ذلك لخط المصحف العثماني، و تركوا ما يخالفه امتثالا لأمر الخليفة عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن، و من ثم نشأ الاختلاف بين قراءة الأمصار.
و على هذا (2) يتضح لك أن الاختلاف في القراءات ليس اختلاف تضاد أو تناقض، لاستحالة وقوع ذلك في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و لكنه اختلاف تنوع و تغاير كأن تقول مثلا: هلم أو تعال أو أقبل و كلها بمعنى واحد.
ص: 24
1- حرز الأماني و وجه التهاني المتن ص 100.
2- الكلام هنا للدكتور عطية قابل نصر في الغاية ص 24.
و إنما نشأ هذا الاختلاف تبعا لما تلقاه الصحابة من رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله و سلم-، و لأن الخليفة عثمان رضي الله عنه لم يكتف بإرسال المصاحف وحدها إلى الأمصار لتعليم القرآن، و إنما أرسل معها جماعة من قراء الصحابة يعلمون الناس القرآن بالتلقين و قد تغايرت قراءاتهم بتغاير رواياتهم، و لم تكن المصاحف العثمانية ملزمة بقراءة معينة لخلوها من النقط و الشكل لتحتمل عند التلقين الوجوه المروية، و قد أقرأ كل صحابي أهل إقليمه بما سمعه تلقيا من رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله و سلم-، و هي قراءة يحتملها رسم المصحف العثماني الذي أرسل منه نسخ إلى جميع الآفاق، فمثلا: لفظ (فتبينوا) من قول اللّه تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (1) من غير نقط يحتمل قراءة:
(فتثبتوا).
و على هذا فقد تمسك أهل كل إقليم بما تلقوه سماعا من الصحابي الذي أقرأهم و تركوا ما عداه، و لهذا ظهر الخلاف بين القراءات.).
ص: 25
1- سورة الحجرات (6).
القراءات المتواترة
اشارة
و هي عبارة عن اختلاف الكيفيات في تلاوة اللفظ القرآني المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم، و نسبتها إلى قائليها المتصل سندهم برسول اللّه- صلى الله عليه و سلم، و لزيادة الإيضاح يجب معرفة المصطلحات الآتية:
1- القراءة:
و يريدون بها الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة للّفظ القرآني على ما تلقاه مشافهة متصلا سنده برسول اللّه صلى الله عليه و سلم، فيقولون مثلا: قراءة عاصم، قراءة نافع المدني، قراءة الكسائي ... و هكذا.
2- الرواية:
و يريدون بها ما نسب لمن روى عن إمام من الأئمة العشرة من كيفية قراءته للّفظ القرآني، و بيان ذلك أن لكل من الأئمة القراء راويين، اختار كل منهما رواية عن ذلك الإمام (1) في إطار قراءته، و قد عرف بها ذلك
ص: 26
1- الأئمة العشرة القراء هم: - نافع المدني: هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان، و كان إمام الهجرة، و توفي بها سنة 169 ه تسع و ستين و مائة. - ابن كثير: هو عبد اللّه بن كثير المكي، إمام أهل مكة، و ولد بها سنة 45 ه و توفي بمكة سنة 120 ه عشرين و مائة. - أبو عمرو البصري: هو زبان بن العلا بن عمار بن العريان المازني التميمي البصري، ولد بمكة سنة 68 ه، و قيل 65، و قيل اسمه يحيى و قيل اسمه كنيته، و توفي بالكوفة الغراء سنة 154 ه أربع و خمسين و مائة. - ابن عامر: هو عبد اللّه بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق، في خلافة الوليد بن عبد الملك، و يكنى أبا عمرو، و هو من التابعين قال ابن عامر: ولدت سنة ثمان من الهجرة بضيعة يقال لها رحاب، و قبض رسول اللّه صلى الله عليه و سلم ولي سنتان، و توفي بدمشق سنة 118 ه ثمان عشرة و مائة. - عاصم الكوفي: هو عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي و يكنى أبا بكر، و هو من التابعين و كان شيخ الإقراء، و من أحسن الناس صوتا بالقرآن، و توفي بالكوفة سنة 127 ه سبع و عشرين و مائة. - حمزة الكوفي: هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات، و يكنى أبا عمارة، ولد سنة 80 ه ثمانين، و كان تاجرا عابدا، متورعا، و توفي في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 156 ه ست و خمسين و مائة. - الكسائي الكوفي: هو علي بن حمزة النحوي، و يكنى أبا الحسن و قيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة، و توفي ببلدة يقال لها: رنبويه، سنة 189 ه تسع و ثمانين و مائة من هجرة الرسول صلى الله عليه و سلم. - أبو جعفر المدني: هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، توفي بالمدينة سنة 128 ه ثمان و عشرين و مائة. - يعقوب الحضرمي: هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، و توفي بالبصرة سنة 250 ه، خمسين و مائتين. - خلف البزار: هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي ولد سنة 150 ه، خمسين و مائة، و حفظ القرآن و هو ابن عشر سنين، و توفي ببغداد سنة 229 ه تسع و عشرين و مائتين.
الراوي (1) و نسبت إليه فيقال مثلا: رواية حفص عن عاصم، رواية ورش عنم.
ص: 28
1- و إذا أردنا أن نتعرف على الرواية العشرين نعلم أن لكل إمام من الأئمة العشرة عنه راويان، يتم بذلك عشرون راويا: - راويا نافع: قالون، و ورش: 1- قالون: هو عيسى بن مينا المدني معلم العربية، و يكنى أبا موسى، و قالون لقب له، يروى أن نافعا لقبه به لجودة قراءته، لأن قالون بلسان الروم «جيد» ولد سنة 120 ه عشرين و مائة، و توفي بالمدينة سنة 220 ه عشرين و مائتين. 2- ورش: هو عثمان بن سعيد المصري، و يكنى أبا سعيد و ورش لقب له، لقب به لشدة بياضه، و توفي بمصر سنة 197 ه سبع و تسعين و مائة. - راويا ابن كثير: البزي، و قنبل: 3- البزي: هو أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن أبي بزة، المؤذن المكي، و يكنى أبا الحسن ولد سنة 170 ه سبعين و مائة، و توفي بمكة سنة 250 ه خمسين و مائتين. 4- قنبل: هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي، و يكنى أبا عمرو، و يلقب بقنبل، و توفي بمكة سنة 291 ه، إحدى و تسعين و مائتين. راويا أبي عمرو: الدوري، و السوسي: 5- الدوري: هو أبو عمرو حفص بن عبد العزيز الدوري النحوي، و الدور موضع ببغداد، و توفي سنة 246 ه ست و أربعين و مائتين. 6- السوسي: هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد اللّه السوسي، توفي سنة 261 ه إحدى و ستين و مائتين. - راويا ابن عامر: هشام، و ابن ذكوان: 7- هشام: هو هشام بن عمار بن نصير القاضي الدمشقي، و يكنى أبا الوليد، توفي سنة 245 ه خمس و أربعين و مائتين. 8- ابن ذكوان: هو عبد اللّه بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي، و يكنى أبا عمرو، ولد سنة 173 ه ثلاث و سبعين و مائة، و توفي بدمشق سنة 242 ه اثنين و أربعين و مائتين. - راويا عاصم: شعبة، و حفص: 9- شعبة: هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي، ولد سنة 95 ه خمس و تسعين، و توفي سنة 193 ه ثلاث و تسعين و مائة بالكوفة. 10- حفص: هو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي، و يكنى أبا عمر، و كان ثقة، قال ابن معين: هو أقرأ من أبي بكر، توفي سنة 180 ه، ثمانين و مائة. - راويا حمزة: خلف، و خلاد: 11- خلف: هو خلف بن هشام البزار، و يكنى أبا محمد، توفي سنة 229 ه تسع و عشرين و مائتين. 12- خلاد: هو خلاد بن خالد، و يقال ابن خليد الصيرفي، توفي سنة 220 ه بالكوفة عشرين و مائتين. - راويا الكسائي: أبو الحارث، و حفص الدوري: 13- أبو الحارث: هو الليث بن خالد البغدادي، توفي سنة 240 ه أربعين و مائتين. 14- حفص الدوري: هو الراوي عن أبي عمرو، و قد سبق ذكره. - راويا أبي جعفر: ابن وردان، و ابن جماز: 15- ابن وردان: هو أبو الحارث عيسى بن وردان المدني، توفي بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة و السلام سنة 260 ه ستين و مائتين. 16- ابن جماز: هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني توفي بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة و السلام سنة 170 ه سبعين و مائة. - راويا يعقوب: رويس، و روح: 17- رويس: هو أبو عبد اللّه محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، و رويس لقب له توفي بالبصرة سنة 28 ه ثمان و ثلاثين و مائتين. 18- روح: هو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي، توفي سنة 234 ه أربع و ثلاثين و مائتين. - راويا خلف: إسحاق، و إدريس: 19- إسحاق: هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراث المروزي، توفي سنة 286 ه ست و ثمانين و مائتين من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه و سلم. 20- إدريس: هو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد، توفي سنة 292 ه اثنين و تسعين و مائتين من هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه و سلم.
نافع .. و هكذا.
3- الطريق:
و هو ما نسب للناقل عن الرواية و إن سفل كما يقولون: هذه رواية ورش من طريق الأزرق.
ص: 30
الأحرف السبعة و نزول القرآن الكريم بها
اشارة
لقد تواتر عن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف، فقد ثبت عن ابن عباس- رضي اللّه عنهما- أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: «أقرأني جبريل علي حرف فراجعته فلم أزل أستزيده و يزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» (1).
و معنى أستزيده: أي: أطلب من جبريل- عليه السلام- أن يطلب من اللّه- عز و جل- الزيادة عن الحرف تخفيضا على الأمة و رحمة و توسعة عليها، حتى انتهى إلى سبعة كما ثبت أن المسور بن مخرمة و عبد الرحمن بن عبد القاري سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلبّبته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال:
أقرأنيها رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فقلت: كذبت فإن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم:
«أرسله ... اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «كذلك أنزلت». ثم قال: «اقرأ يا عمر»، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «كذلك أنزلت ... إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه» (2).
ص: 31
1- رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن انظر فتح الباري ج 9 ص 23 رقم 4991، كما رواه مسلم في باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف و اللّفظ للبخاري- رضي اللّه عنهما-.
2- أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب «أنزل القرآن على سبعة أحرف» انظر فتح الباري ج 9 ص 23 ح 4992، كما رواه مسلم بلفظ آخر في باب «بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» و معنى أساوره: أقاتله و أواثبه، و معنى فلببته بردائه: أي جمعت عليه رداءه عند لبته حتى لا يفك مني، و في هذا دليل على ما كانوا يحرصون و يحافظون على ما سمعوه من النبي صلى الله عليه و سلم.
و قد اختلفوا في المراد بالأحرف السبعة اختلافا كثيرا، و الذي يرجحه المحققون من العلماء: مذهب الإمام أبي الفضل الرازي و هو: أن المراد بهذه الأحرف: الأوجه التي يقع بها التغاير و الاختلاف، و هي لا تخرج عن سبعة:
1- الأول:
اختلاف الأسماء في الإفراد و التثنية، و التذكير و التأنيث مثل قول اللّه تعالى: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ (1) قرئ لفظ: (مسكين) بالإفراد كرواية حفص عن عاصم، و قرئ بالجمع هكذا: (مساكين) و هي قراءة ابن ذكوان و نافع.
2- الثاني:
اختلاف تصريف الأفعال من ماض و مضارع و أمر نحو قوله تعالى:
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً بالبقرة فقد قرئ هكذا على أنه فعل ماض، و قرئ:
(يطوع) على أنه فعل مضارع مجزوم.
ص: 32
1- سورة البقرة (184) و تفصيل القراءة فيها كالآتي: قرأ نافع و ابن ذكوان بحذف التنوين و خفض الميم هكذا (فدية طعام مساكين) و قرأ هشام و أبو عمر و الكوفيون و ابن كثير بتنوين (فدية) و رفع الميم في طعام هكذا (فدية طعام مساكين)، و قرأ نافع و ابن عامر (مساكين) بالجمع و ترك التنوين، و قرأ هشام بالتنوين و رفع الميم و جمع مساكين، و قرأ الباقون بالتنوين و رفع الميم. قال الشاطبي: و فدية نون و ارفع الخفض بعد في طعام لذي غصن دنا و تذللا مساكين مجموعا و ليس منونا و يفتح منه النون عم و أنجلا
3- الثالث:
اختلاف وجوه الإعراب، نحو قوله تعالى: وَ لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ بالبقرة، فقد قرئ بضم التاء و رفع اللام على أن لا نافية، و قرئ بفتح التاء و جزم اللام على أن لا ناهية.
4- الرابع:
الاختلاف بالنقص و الزيادة كقول اللّه تعالى: وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ بآل عمران، فقد قرئ هكذا بإثبات الواو قبل السين، و قرئ بحذفها.
5- الخامس:
5- الخامس:
الاختلاف في التقديم و التأخير كقوله تعالى: وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا بآل عمران فقد قرئ هكذا بتقديم و قاتلوا و تأخير و قتلوا، و قرئ بتقديم و قتلوا و تأخير و قاتلوا.
6- السادس:
الاختلاف بالإبدال أي جعل حرف مكان آخر كقول اللّه تعالى: هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ بيونس قرئ هكذا بتاء مفتوحة فباء ساكنة، و قرئ بتاءين الأولى مفتوحة و الثانية ساكنة (تتلو).
7- السابع:
الاختلاف في اللهجات، كالفتح و الإمالة و الإظهار و الإدغام، و التسهيل و التحقيق، و التفخيم و الترقيق، و كذا يدخل في هذا النوع الكلمات التي اختلفت فيها لغة القبائل نحو: (خطوات) تقرأ بتحريك الطاء بالضم، و تقرأ بتسكينها، و نحو: (بيوت) تقرأ بضم الباء و تقرأ بكسرها (1).
ص: 33
1- كذا ورد في الوافي للشيخ القاضي ص 7.
الحكمة من إنزال القرآن الكريم بالأحرف السبعة
تتلخص الحكمة في إنزال القرآن الكريم على الأحرف السبعة في أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ألسنتهم مختلفة، و لهجاتهم متباينة، و يتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي نشأ عليها، و تعود لسانه التخاطب بها، فصارت طبيعة من طبائعه، و سجية من سجاياه، بحيث لا يمكنه العدول عنها إلى غيرها، فلو كلفهم اللّه- تعالى- مخالفة لهجاتهم لشق عليهم ذلك، و أصبح من قبيل التكليف بما لا يطاق، فاقتضت رحمة اللّه- تعالى- بهذه الأمة أن يخفف و ييسر عليها حفظ كتابها و تلاوة دستورها كما يسر لها أمر دينها فأذن لنبيه أن يقرئ أمته القرآن على سبعة أحرف فكان صلى الله عليه و سلم يقرئ كل قبيلة بما يوافق لغتها و يلائم لسانها.
و لعل من الحكمة أيضا أن يكون ذلك معجزة للنبي على صدق رسالته حيث ينطق صلى الله عليه و سلم القرآن الكريم بهذه الأحرف السبعة، و تلك اللهجات المتعددة، و هو النبي الأمي الذي لا يعرف سوى لهجة قريش.
صلة القراءات السبع بالأحرف السبعة
و أما عن صلة القراءات السبع بالأحرف السبعة المذكورة في الحديث فليعلم أن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على الأمة، ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الأخيرة مما حدا بالخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى كتابة المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار، و أحرق كل ما عداها، و ليس الأمر كما توهمه بعض الناس من أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة.
و الصواب أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ الناس بها اليوم هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن العظيم، و ورد بها الحديث، و هذه القراءات العشرة جميعها موافقة لخط مصحف من المصاحف العثمانية التي بعث بها الخليفة عثمان إلى الأمصار، بعد أن أجمع الصحابة عليها، و على طرح كل ما يخالفها.
ص: 34
آداب حامل القرآن (1)
آداب حامل القرآن (1) من آداب حامل القرآن أن يكون على أكمل الأحوال و أكرم الشمائل، و أن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، و أن يكون مصونا عن دني ء الاكتساب شريف النفس مرتفعا على الجبابرة و الجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين و أهل الخير و المساكين، و أن يكون متخشعا ذا سكينة و وقار، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء ارفعوا رءوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس.
و عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، و بنهاره إذ الناس مفرطون، و بحزنه إذ الناس يفرحون، و ببكائه إذ الناس يضحكون، و بصمته إذ الناس يخوضون، و بخشوعه إذ الناس يختالون.
و عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل و يتفقدونها في النهار.
و عن الفضيل بن عياض قال: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم.
و عنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، و لا يسهو مع من يسهو، و لا يلغو مع من يلغو؛ تعظيما لحق القرآن.
و من أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبيل رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «اقرءوا القرآن، و لا تأكلوا به و لا تجفوا عنه، و لا تغلوا فيه».
و عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: «اقرءوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه، و لا يتأجلونه». رواه بمعناه من رواية سهل بن سعد.
ص: 35
1- ورد هذا المبحث في التبيان للنووي ص 28.
و معناه: يتعجلون أجره إما بمال و إما سمعة و نحوها.
و عن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال: دخل رجلان من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و سلم مسجدا فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل. فقال أحدهما: إنا للّه و إنا إليه راجعون سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و سلم يقول: «سيجي ء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه»، و هذا الإسناد منقطع، فإن الفضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة.
و أما أخذه الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء منهم الزهري و أبو حنيفة.
و عن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، و هو قول الحسن البصري و الشعبي و ابن سيرين، و ذهب عطاء و مالك و الشافعي و آخرون إلى جوازها إن شارطه و استأجره إجارة صحيحة، و قد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة و احتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت: أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا. فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: «إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها».
و هو حديث مشهور رواه أبو داود و غيره و بآثار كثيرة عن السلف.
و أجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين:
أحدهما: أن في إسناده مقالا.
و الثاني: أنه كان تبرّع بتعليمه فلم يستحق شيئا. ثم أهدى إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. و اللّه أعلم.
ينبغي أن يحافظ على تلاوته و يكثر منها، و كان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة، و عن بعضهم في كل شهر ختمة، و عن بعضهم في كل عشر ليال ختمة، و عن بعضهم في كل ثمان ليال، و عن
ص: 36
بعضهم في كل سبع ليال و هم الأكثر، و عن بعضهم في كل ست ليال، و عن بعضهم في كل خمس، و عن بعضهم في كل أربع، و عن كثيرين في كل ثلاث، و عن بعضهم في كل ليلتين، و ختم بعضهم في كل يوم و ليلة ختمة، و منهم من كان يختم في كل يوم و ليلة ختمتين، و منهم من كان يختم ثلاثا، و ختم بعضهم ثماني ختمات أربعا بالليل، و أربعا بالنهار، فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل و اليوم: عثمان بن عفان رضي الله عنه، و تميم الداري، و سعيد بن جبير، و مجاهد، و الشافعي، و آخرون. و من الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات: سليم ابن عمر رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه.
و روى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات.
و روى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات. قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار أربع ختمات و بالليل أربع ختمات. و هذا أكثر ما بلغنا من اليوم و الليلة.
و روى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان- من عبّاد التابعين رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر و العصر، و يختمه أيضا فيما المغرب و العشاء في رمضان ختمتين و سيأتي و كانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل.
و روى أبو داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن فيما بين المغرب و العشاء.
و عن منصور قال: كان عليّ الأزدي يختم فيما بين المغرب و العشاء كل ليلة من رمضان.
و عن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن.
و أما الذي يختم في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين: عثمان
ص: 37
ابن عفان و تميم الداري و سعيد بن جبير رضي الله عنهم، ختمة في كل ركعة في الكعبة.
و أما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون نقل عن: عثمان بن عفان و عبد اللّه بن مسعود و زيد بن ثابت و أبي بن كعب رضي الله عنهم، و عن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن زيد و علقمة و إبراهيم- رحمهم اللّه-، و الاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف و معارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه، و كذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين و مصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، و إن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل و الهذرمة، و قد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم و ليلة، و يدل عليه الحديث الصحيح عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» (1).
و أما وقت الابتداء و الختم لمن يختم في الأسبوع، فقد روى أبو داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة و يختمه ليلة الخميس.
و قال الإمام أبو حامد الغزالي- رحمه اللّه تعالى- في الإحياء: الأفضل أن يختم ختمة بالليل و أخرى بالنهار، و يجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، و يجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل أول النهار و آخره.
و روى ابن أبي داود عن عمر بن مرة التابعي: قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار.م.
ص: 38
1- رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و غيرهم قال الترمذي حديث حسن صحيح و اللّه أعلم.
و عن طلحة بن مصرف التابعي الجليل قال: من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، و أية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح.
و عن مجاهد مثله.
و روى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، و إذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي». قال الدارمي: هذا حسن عن سعد.
و عن حبيب بن أبي ثابت التابعي: أنه كان يختم قبل الركوع. قال ابن أبي داود: و كذا قال أحمد بن حنبل- رحمه اللّه تعالى- و في هذا الفصل بقايا ستأتي إن شاء اللّه تعالى.
و ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر. قال اللّه تعالى:
مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ.
و ثبت في الصحيح عن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أنه قال: «نعم الرجل عبد اللّه لو كان يصلي من الليل». و في الحديث الآخر من الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم قال: «يا عبد اللّه لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه».
و روى الطبراني و غيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: «شرف المؤمن قيام الليل».
و الأحاديث و الآثار في هذا كثيرة، و قد جاء عن أبي الأحوص الحبشي قال:
إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا- أي: يأتيه ليلا- فيسمع لأهله دويّا كدوي النحل، قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون؟.
و عن إبراهيم النخعي كان يقول: اقرءوا من الليل و لو حلب شاة.
ص: 39
و عن يزيد الرقاشي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. قلت: و إنما رجحت صلاة الليل و قراءته لكونها أجمع للقلب، و أبعد عن الشاغلات و الملهيات و التصرف في الحاجات، و أصون عن الرياء و غيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل. فإن الإسراء برسول اللّه صلى الله عليه و سلم كان ليلا، و حديث: «ينزل ربكم إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له ...» الحديث. و في الحديث أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: «في الليل ساعة يستجيب اللّه فيها الدعاء كل ليلة».
و روى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سليمان الأنماطي قال: رأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول:
لو لا الذين لهم ورد يقومونا و آخرون لهم سرد يصومونا
لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعونا
و اعلم أن فضيلة القيام بالليل و القراءة فيه تحصل بالقليل و الكثير، و كلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه و إلا أن يضر بنفسه، و مما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، و من قام بمائة آية كتب من القانتين، و من قام بألف آية كتب من المقسطين». رواه أبو داود و غيره.
و حكى الثعلبي عن ابن عباس- رضي اللّه عنهما- قال: «من صلى بالليل ركعتين فقد بات للّه ساجدا و قائما».
ص: 40
فصل في الأمر بتعهد القرآن و التحذير من تعريضه للنسيان
اشارة
ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها» رواه البخاري و مسلم.
و عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها و إن أطلقها ذهبت» رواه البخاري و مسلم.
و عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، و عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» رواه أبو داود و الترمذي و تكلم فيه.
و عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «من قرأ القرآن ثم نسيه لقي اللّه- عز و جل- يوم القيامة و هو أجذم» رواه أبو داود و الترمذي.
فصل فيمن ينام عن ورده
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شي ء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر و صلاة الظهر كتب له كأنه قرأه بالليل» رواه مسلم.
و عن سليمان بن يسار قال: قال أبو أسيد رضي الله عنه: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت و كان وردي سورة البقرة فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. رواه ابن أبي داود.
ص: 41
في كتابة القرآن و إكرام المصحف
في كتابة القرآن و إكرام المصحف (1) اعلم- أيدك اللّه تعالى بنصره- أن القرآن العظيم كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم على ما هو في المصاحف اليوم، و لكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله و طوائف يحفظون أبعاضا منه، فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه و قتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم و اختلاف من بعدهم فيه فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف و جعله في بيت حفصة أم المؤمنين- رضي اللّه عنها- فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه و انتشر الإسلام خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شي ء من القرآن أو الزيادة فيه فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف و بعث بها إلى البلدان و أمر بإتلاف ما خالفها، و كان فعله هذا باتفاق منه و من على بن أبي طالب و سائر الصحابة و غيرهم رضي الله عنهم. و إنما لم يجعله النبي صلى الله عليه و سلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادة و نسخ بعض المتلو، و لم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه و سلم فلما أمن أبو بكر و سائر أصحابه ذلك التوقع و اقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنهم و اختلفوا في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان. فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ: فبعث إلى البصرة إحداهن، و إلى الكوفة أخرى، و إلى الشام أخرى، و حبس عنده أخرى، و قال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان سبعة مصاحف: بعث واحدا إلى مكة، و آخر إلى البحرين، و آخر إلى البصرة، و آخر إلى الكوفة، و حبس بالمدينة المنورة واحدا، و هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، و فيه أحاديث كثيرة في الصحيح. و في المصحف ثلاث لغات ضم الميم و كسرها و فتحها، فالضم و الكسر مشهورتان، و الفتح ذكرها أبو جعفر
ص: 42
1- انظر التبيان ص 110.
النحاس و غيره.
اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف و تحسين كتابتها و تبيينها و إيضاحها و تحقيق الحظ دون مشقة، و تعليقه.
قال العلماء: و يستحب نقط المصحف و شكله فإنه صيانة من اللحن فيه و تصحيفه، و أما كراهة الشعبي و النخعي النقط، فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، و قد أمن ذلك اليوم فلا منع، و لا يمتنع من ذلك لكونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم و بناء المدارس و الرباط و غير ذلك. و اللّه أعلم.
و لا تجوز كتابة القرآن بشي ء نجس، و تكره كتابته على الجدران عندنا، و فيه مذاهب، و أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، و أنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها.
أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف و احترامه. قال أصحابنا و غيرهم: و لو ألقاه مسلم في القاذورات و العياذ باللّه تعالى صار الملقي كافرا.
قالوا: و يحرم توسده، بل توسد آحاد كتب العلم حرام، و يستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء و الأخيار فالمصحف أولى، و قد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه، و روينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه، و يقول: «كتاب ربي. كتاب ربي».
و تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم للحديث المشهور في الصحيحين: «أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» و يحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحها: لا يصح. و الثاني: يصح. و يؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه و يمنع المجنون و الصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من
ص: 43
انتهاك حرمته، و هذا المنع واجب على الولي و غيره ممن رآه يتعرض لحمله.
و يحرم على المحدث مس المصحف و حمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد، و يحرم مس الخريطة و الغلاف و الصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار، و قيل لا تحرم هذه الثلاثة و هو ضعيف، و لو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم من اللوح.
و إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه، ففي جوازه وجهان لأصحابنا:
أظهرها: جوازه، و به قطع العراقيون من أصحابنا؛ لأنه غير ماس و لا حامل.
و الثاني: تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة، و الورقة كالجميع، و أما إذا لف كمه على يده و قلب الورقة فحرام بلا خلاف، و غلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين، و الصواب القطع بالتحريم، لأن القلب يقع باليد لا بالكم.
إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا، إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام، و إن لم يحملها و لم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح:
جوازه. و الثاني: تحريمه. و الثالث: يجوز للمحدث، و يحرم على الجنب.
و إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم و فيه آيات من القرآن الكريم أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الحبر المنقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأنه ليس بمصحف، و فيه وجه أنه حرام.
و قال أقضى القضاة أبو حسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن، و لا يجوز لبسها بلا خلاف لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، و هذا الذي ذكره أو قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما
ص: 44
رأيته بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني و غيره بجواز لبسها، و هذا هو الصواب. و اللّه أعلم.
و أما كتب تفسير القرآن، فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها و حملها، و إن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يحرم. و الثاني: يحرم. و الثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم و إن لم يتميز لم يحرم. قلت (1): و يحرم المس إذا استويا. قال صاحب التتمة من أصحابنا: و إذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. و أما كتب حديث رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، و الأولى ألا تمس إلا على طهارة و إن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب، و فيه وجه أنه يحرم، و هو الذي في كتب الفقه.
و أما المنسوخ تلاوته كالشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة- و غير ذلك- فلا يجوز مسه و لا حمله، قال أصحابنا: و كذلك التوراة و الإنجيل.
إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف و لا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قال به جماهير أصحابنا و غيرهم من العلماء. و قال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا: يحرم، و غلطه أصحابنا في هذا.
قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا أنه مكروه، و المختار أنه ليس بمكروه.
و من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف، سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. و أما من لم يجد ماء و لا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، و لا يجوز له مس المصحف لأنه محدث، جوزنا له
ص: 45
1- القول هنا للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي صاحب التبيان في آداب حملة القرآن ص 115.
الصلاة للضرورة و لو كان معه مصحف و لم يجد من يودعه عنده و عجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: و لا يلزمه التيمم، و فيما قاله نظر، و ينبغي أن يلزمه التيمم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه و لو كان محدثا للضرورة.
هل يجب على الولي و المعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف و اللوح اللذين يقرأ فيهما؟ فيه وجهان مشهوران أصحهما عند الأصحاب: لا يجب للمشقة.
يصح بيع المصحف و شراؤه، و لا كراهة في شرائه، و في كراهة بيعه وجهان لأصحابنا أصحهما و هو نص الشافعي أنه يكره، و من قال لا يكره بيعه و شراؤه الحسن البصري و عكرمة و الحكم بن عيينة، و هو مروي عن ابن عباس، و كرهت طائفة من العلماء بيعه و شراءه، و حكاه ابن المنذر عن علقمة و ابن سيرين و النخعي و شريح و مسروق و عبد اللّه بن زيد، و روي عن عمر و أبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه، و ذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء و كراهة البيع، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس و سعيد بن جبير و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه. و اللّه أعلم.
ص: 46
حول شكل المصحف و إعجامه
- الشكل:
حول شكل المصحف و إعجامه (1)
هو ما يدل على عوارض الحرف من حركة و سكون سواء أ كان ذلك في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها.
يقال: شكل الكتاب: إذا قيده بالإعراب، و أشكل الكتاب: إذا أزال إشكاله و التباسه.
و قال ابن منظور: و شكل الكتاب يشكله شكلا و أشكله، فهو مشكول إذا قيده بالإعراب، و أعجمت الكتاب إذا نقطته.
و يقال: أشكلت الكتاب بالألف، كأنك أزلت به عنه الإشكال و الالتباس (2).
و يقال: أعجم الحرف إذا نقطه بالسواد كالتاء عليها نقطتان، و حروف المعجم هي الحروف المقطعة التي يختص أكثرها بالنقط من بين سائر حروف الاسم.
فالشكل: خاص ببيان ما يعرض للحرف من حركة أو سكون.
- و الإعجام:
خاص ببيان ذات الحرف و تمييزه عن غيره، و قد اتفق المؤرخون على أن العرب في عهدهم الأول لم يكونوا يعرفون الشكل بمعناه الاصطلاحي، بل كانوا ينطقون بالألفاظ مضبوطة مشكولة بحسب سليقتهم و فطرتهم العربية من غير لحن و لا غلط، لما كان متأصلا في نفوسهم من الفصاحة و البلاغة، و استقامة ألسنتهم على النطق بالألفاظ المؤلفة على حسب الوضع الصحيح من غير حاجة إلى معرفة القواعد.
ص: 47
1- انظر البيان في علوم القرآن ص 296.
2- و راجع لسان العرب: 2311، 2827 و مختار الصحاح للرازي: ص 367- 440.
لذلك لما كتب عثمان المصاحف- في العهد الأول- جردها من الشكل و النقط، اعتمادا على هذه السليقة، و على أن المعول عليه في القرآن هو التلقي و الرواية، فلم يكن بهم حاجة إلى الشكل.
و أيضا حتى تصلح الكلمة لأن تقرأ بوجوه القراءات الثابتة التي يحتمها الرسم مجردا من النقط و الشكل.
و لكنهم اختلفوا في النقط، فمنهم من يرى أن الإعجام كان معروفا قبل الإسلام لتمييز الحروف المتشابهة، غير أنه ترك عند كتابة المصاحف لما ذكرنا.
و منهم من يرى أن الإعجام لم يعرف إلا من طريق أبي الأسود الدؤلي، ثم اشتهر و وضع في القرآن في عهد عبد الملك بن مروان. و الظاهر الأول لأنه يبعد جدّا ألا يكون للحرف علامات تميز المتشابهات بعضها عن بعض.
و مهما يكن من شي ء فقد اشتدت الحاجة إليه حينما اتسعت رقعة الإسلام، و جاوز حدود بلاد العرب و دخل الناس من غير العرب في الدين، و فسدت الفطرة العربية، و دخل اللحن في الكلام، و بدأ الإلباس و الإشكال في قراءة القرآن. حتى قيل: إن زيادا و الي البصرة سأل أبا الأسود الدؤلي أن يضع للناس علامات يعرفون بها كتاب اللّه تعالى، فاستعفاه من ذلك، ثم حدث أن أبا الأسود سمع قارئا يقرأ قول اللّه تعالى: أَنَّ اللَّهَ بَرِي ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ بالتوبة بجر اللام في لفظ (و رسوله) عطفا على المشركين، بينما هي في الآية مرفوعة في قراءة السبعة (1) على أنها مستأنفة، أي و رسوله بري ء من المشركين كذلك.
أو منصوبة- كما في قراءة يعقوب برواية روح و زيد، و هي قراءة).
ص: 48
1- قرأ يعقوب برواية روح و زيد (إن اللّه بري ء من المشركين و رسوله) بالنصب مثل قراءة الحسن، و قرأ الباقون (و رسوله) بالرفع انظر المبسوط (193) و ابن خالويه في الشواذ (51).
الحسن و ابن أبي إسحاق، و عيسى بن عمرو- عطفا على اسم (إن) و هو الظاهر، أي: أن اللّه و رسوله بريئان من المشركين، لكن اللّه- تعالى- لا يجمع معه غيره في ضمير واحد، فلذلك فصل بين اللفظين اكتفاء بالعطف.
المهم أن أبا الأسود فزع لهذا اللحن المغير للمعنى- على قراءة الجر- و قال: «عز وجه اللّه أن يبرأ من رسوله»، و ذهب إلى البصرة، و قال له: قد جئتك إلى ما سألت (1).
و قيل: أن أبا الأسود لما سمع ذلك رفع الأمر إلى علي رضي اللّه تعالى عنه، فكان ذلك سبب وضع النحو. و اللّه تعالى أعلم (2).
المهم أن أبا الأسود وضع الشكل أولا، لأن الحاجة إلى معرفة حال الحرف أمس من الحاجة إلى الإعجام الذي يميز الحرف من الحرف، فوضع على الحرف المفتوح نقطة من أوله، و المضموم نقطة من آخره، و المكسور نقطة تحت أوله.
و يروي الداني أن المبتدئ بذلك كان نصر بن عاصم الليثي، و أنه الذي خمسها و عشرها.
و يروى أيضا أن ابن سيرين كان عنده مصحف نقطه يحيى بن يعمر، و أن يحيى أول من نقطها، ثم يقول: «و هؤلاء الثلاثة من جلة تابعي البصريين»، و أكثر العلماء على أن المبتدئ بذلك أبو الأسود الدؤلي، و جعل الحركات و التنوين لا غير، و أن الخليل بن أحمد هو الذي جعل الهمزة و التشديد و الروم و الإشمام.
و أما ابن عطية فيرى أن عبد الملك بن مروان هو الذي أمر به (فتجردة.
ص: 49
1- فصل الخطاب في سلامة القرآن: ص 64.
2- روح المعاني: 10/ 47 و قال الألوسي: و يحكى أن أعرابيا سمع رجلا يقرؤها- أي بالجر- فقال: إن كان اللّه تعالى بريئا من رسوله، فأنا منه بري ء فلببه الرجل إلى عمر رضي الله عنه فحكى الأعرابي قراءته، فعندها أمر عمر بتعليم العربية.
لذلك الحجاج- بواسط- و جدّ فيه، و زاد تحزيبه، و أمر- و هو والي العراق- الحسن بن يعمر بذلك ..).
و أما وضع الأعشار فيه: فمر بي (1) في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك. و قيل: أن الحجاج فعل ذلك و ذكر أبو عمرو المسرافي عن قتادة أنه قال: بدءوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا، و هذا كالابتكار و هؤلاء الأربعة (أبو الأسود، و نصر، و يحيى، و الحسن) من جلة علماء التابعين، و قد عاشوا في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، و من هنا يمكننا أن نقول:
أن أحداث الشكل تبعه أحداث النقط مع تقارب في الزمن.
و يمكننا أن نقول في التوفيق بين الأربعة: أن أبا الأسود هو أول من بدأ على الإطلاق في شكل المصاحف بطريقة النقط، فوضع على الحرف المفتوح نقطة من أوله، و المضموم من آخره، و المكسور نقطة تحت أوله، و الساكن نقطتين من فوقه. و لكن بطريقة فردية. و أن نصر بن عاصم الليثي هو الذي زاد على الشكل التخميس (2) و التعشير، و أن الحسن و يحيى هما اللذان نشرا المصحف على حالته الأخيرة بأمر الوالي، فأخذ الصفة الرسمية و ذاع بين الناس.
قال الزرقاني: ثم طفق الناس ينهجون منهج أبي الأسود، ثم امتد الزمان بهم فبدءوا يزيدون و يبتكرون، حتى جعلوا للحرف المشدد علامة كالقوس، و لألف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطها على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة. و دامت الحال على هذا حتى جاء عبد الملك بن مروان، فرأى بنافذ بصيرته أن يميز ذوات الحروف من بعضها، و أن يتخذ سبيله إلى).
ص: 50
1- هذا القول منسوب للدكتور السيد إسماعيل علي مدرس بجامعة الأزهر في البيان ص 300.
2- التخميس: كتابة لفظ خمس عند رأس كل خمس آيات، و التعشير: كتابة لفظ عشر عند رأس كل عشر آيات، و منهم من يكتفي بكتابة حرفي (خ)، (ع).
ذلك التمييز بالإعجام و النقط، على نحو ما تقدم تحت العنوان السابق و هنالك اضطر أن يستبدل بالشكل الأول الذي هو النقط، شكلا جديدا هو ما نعرفه اليوم من علامات الفتحة و الكسرة و الضمة و السكون. الذي اضطره إلى هذا الاستبدال، أن لو أبقى العلامات الأولى على ما هي عليه نقطا، ثم جاءت هذه الأخرى- أي إعجام الحروف- نقطا كذلك لتشابهها و اشتبه الأمر فميز بين الطائفتين بهذه الطريقة. و نعما فعل.
ثم جرى تحسينات على هذا النقط و التشكيل كان من أكملها ما جرى على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي حيث جعل الهمز و التشديد و الروم و الإشمام، حتى أصبحت الآن لها صفة الحاجة الملحة التي لا غنى عنها، و لا يكاد يسد مسدها شي ء.
تجزئة القرآن و تحزيبه:
لم تقتصر الإضافات إلى الرسم العثماني للمصاحف على النقط و الشكل، بل تعدتهما إلى إضافات أخرى مثل علامات الأجزاء حيث جزء العلماء القرآن تجزئات شتى، منها: التجزئة إلى ثلاثين جزءا، و أطلقوا على كل واحد منها اسم الجزء، بحيث لا يخطر بالبال عند الإطلاق غيره، فإذا قال قائل: قرأت جزءا من القرآن، تبادر للذهن أنه قرأ جزءا من الأجزاء الثلاثين.
ثم جزءوا كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثين إلى جزءين، و قد أطلقوا على كل واحد منها اسم الحزب، فصارت الأحزاب ستين حزبا، ثم جزءوا الحزب إلى أربعة أرباع.
ثم وضعوا علامات المد و الوقف، و أسماء السور، و ترقيم آياتها، و بيان المكي منها قبل بدء السورة كالعنوان لها و غير ذلك مما هو معروف لدى القراء و المعلمين.
ص: 51
حكم نقط المصحف و شكله:
كان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف و شكله و نحوهما مبالغة منهم في المحافظة على القرآن من التزيد و كتابته في المصاحف على هيئة ما كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم فقد أخرج أبو عبيدة و غيره عن ابن مسعود قال: «جردوا القرآن و لا تخلطوه بشي ء» و أخرج عن النخعي أنه كره نقط المصاحف و عنه أيضا أنه أتي بمصحف مكتوب فيه سورة كذا و كذا آية فقال: امح هذا فإن ابن مسعود كان يكرهه.
و عن ابن سيرين أنه كره النقط و الفواتح و الخواتم.
و أجاز ذلك الإمام مالك للمتعلمين فحسب حيث قال: لا بأس بالنقط في المصاحف التي تتعلم فيها العلماء، أما الأمهات فلا.
و قال الحربي في غريب الحديث: قول ابن مسعود: (جردوا القرآن) يحتمل وجهين:
أحدهما: جردوه في التلاوة، و لا تخلطوا به غيره.
الثاني: جردوه في الخط من النقط و التعشير.
قال البيهقي: الأبين أنه أراد: لا تخلطوا به غيره من الكتب، لأن ما خلا القرآن من كتب اللّه إنما يؤخذ عن اليهود و النصارى و ليسوا بمأمونين عليها.
و أخرج ابن أبي داود عن خالد الحذاء قال: رأيت ابن سيرين يقرأ في مصحف منقوط.
و سئل ربيعة بن عبد الرحمن عن شكل القرآن في المصاحف فقال: لا بأس به.
و كذا سئل الحسن عن المصحف ينقط بالعربية فقال: أو ما بلغك كتاب عمر بن الخطاب- رضي اللّه تعالى عنه- أن تفقهوا في الدين و أحسنوا عبارة الرؤيا و تعلموا العربية.
و من خلال هذه الآثار و غيرها يتبين لنا أن سلفنا الصالح اختلفوا في
ص: 52
حكم نقط المصحف و شكله، فمنهم من كرهه كابن مسعود و غيره، و منهم من أجاز التنقيط و كره التخميس و التعشير، و أسماء السور و عدد الآيات و غير ذلك، كالنخعي و الحليمي و غيرهما، و منهم من أجاز ذلك للمتعلمين و منعه في الأمهات كالإمام مالك.
و لكن الحال قد تغيرت عما كان عليه الناس في العهد الأول، فاضطر المسلمون إلى نقط المصحف و شكله، للمحافظة على القرآن من اللحن و التغيير و التصحيف، و بعد أن كان العلماء يكرهون ذلك صار واجبا أو مستحبا لما هو مقرر في علم أصول الفقه من أن الحكم يدور مع علته وجودا و عدما.
قال الإمام النووي ما نصه: (قال العلماء: و يستحب نقط المصحف و شكله، فإنه صيانة من اللحن فيه و تصحيفه، و أما كراهة الشعبي و النخعي النقط، فإنما كرها ذلك في الزمان خوفا من التغيير فيه، و قد أمن ذلك اليوم، فلا منع، و لا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلا يمنع منه كنظائره، كتصنيف العلم، و بناء المدارس و الرباط و غير ذلك و اللّه أعلم (1)).
و قال الداني: «و الناس في جميع أمصار المسلمين من لدن التابعين إلى وقتنا هذا على الترخيص في ذلك في الأمهات و غيرها، و لا يرون بأسا برسم فواتح السور و عدد آياتها، و رسم الخموس و العشور في مواضعها، و الخطأ مرتفع عن إجماعهم».
- احترام المصحف و تقديسه:
ليس- فيما نرى و نسمع- كتاب أحيط بهالة من الإجلال و التقديس، كالقرآن الكريم. حتى لقد وصفه الحق جل شأنه بأنه كتاب مكنون، و حكم بأنه لا يمسه إلا المطهرون، و أقسم على ذلك، حيث قال تعالى: فَلا أُقْسِمُ
ص: 53
1- التبيان في آداب حملة القرآن ص 98.
بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ.
و لذلك كان من إجلال القرآن الكريم و تعظيمه عدم إباحة كتابته على الجدران سواء كانت جدران مساجد أم جدران منازل أم غير ذلك.
أما جدران المساجد فقد اتفق الأئمة على كراهة كتابة شي ء من القرآن عليها. حيث قال المالكية: (إن كانت الكتابة في القبلة كرهت، لأنها تشغل المصلى سواء كان المكتوب قرآنا أو غيره، و لا تكره فيما عدا ذلك).
و قال الشافعية: (يكره كتابة شي ء من القرآن على جدران المسجد و سقوفه، و يحرم الاستناد لما كتب فيه من القرآن، بأن يجعله خلف ظهره).
و قال الحنابلة: (تكره الكتابة على جدران المساجد و سقوفها، و إن كان فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله).
و قال الحنفية: (لا ينبغي الكتابة على جدران المسجد خوفا من أن تسقط و تهان بوطء الأقدام (1)).
فهذه أقوال الأئمة، نجد فيها المالكية يعللون الكراهة بانشغال المصلى، و الحنفية يعللونها بالخوف من سقوط المكتوب، ثم الإجماع منهم جميعا بصفة عامة على الكراهة.
و أما جدران المنازل و ما شابهها، فإن علة الكراهة قائمة بسبب عدم التحرز من تطاير النجاسات، أو عبث الصبيان.
فقد قال القرطبي: و من حرمته- أي القرآن- ألا يكتب على حائط كما يفعل بهذه المساجد المحدثة .. ثم روى عن محمد بن الزبير قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث قال: مر رسول اللّه صلى الله عليه و سلم بكتاب في أرض. فقال لشاب من هذيل: «ما هذا؟» قال: من كتاب اللّه، كتبه يهودي، فقال: «لعن اللّه5.
ص: 54
1- الفقه على المذاهب الأربعة ص 245.
من فعل هذا .. لا تضعوا كتاب اللّه إلا موضعه».
و قال محمد بن الزبير: رأى عمر بن عبد العزيز ابنا له يكتب القرآن على حائط فضربه.
فهذه الرواية- الأخيرة- تبين أنه لو كانت كتابة القرآن على الجدران مباحة لما منع عمر بن عبد العزيز ابنه من الكتابة.
و من تعظيم القرآن الكريم و إجلاله أن لا يصغر (المصحف) كتابة لدرجة عدم إمكان قراءته إلّا بمشقة شديدة، و لا يصغر كلاما، بأن يقال:
مصيحف.
فقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مصحفا صغيرا في يد رجل، فقال: من كتبه؟ قال أنا: فضربه بالدرة، و قال: (عظموا القرآن).
ص: 55
كيفية حفظ و تثبيت القرآن
اشارة
كيفية حفظ و تثبيت القرآن (1)
1- أكثر دائما من الدعاء بحفظ القرآن، فإن القرآن كما قال محمد بن واسع: «.. بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلّوا في نزهة».
و اعلم أن كثرة الدعاء دليل على عدم الاستعجال في الإجابة، جاء في الصحيحين: قال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول:
دعوت فلم يستجب لي».
و كما قيل: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له و يمكنك- و اللّه أعلم- أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم حفّظني كتابك، و اجعلني من العالمين العالمين به.
2- لا يشغلنك الحفظ عن التلاوة، فإن التلاوة وقود الحفظ.
3- لما ذا يحفظ كثير من المسلمين سورة الكهف؟ لأنهم يقرءونها في كل أسبوع مرة، فإن استطعت أن تعامل سور القرآن كلها معاملتك سورة الكهف فافعل.
4- يمكنك قبل الحفظ أن تصلي ركعتين للّه تعالى: «صلاة الحاجة» تسأل اللّه فيهما العون و الصواب و الإخلاص، و يا حبذا لو صليت أيضا صلاة التوبة.
5- قراءة تفسير الآيات التي تريد حفظها.
6- اجعل وردك اليومي في القرآن مرتبطا بالشهر العربي، أو الأسبوع فبالنسبة للشهر العربي يمكنك قراءة جزء أو جزءين أو ثلاثة أجزاء في اليوم، و أما بالنسبة للأسبوع فيمكنك ختم القرآن في كل أسبوع مرة، و من المعلوم جواز ختم القرآن في ثلاثة أيام.
7- لا تبدأ عملك اليومي في مدارسة العلم إلا بعد الانتهاء من ورد
ص: 56
1- انظر عون الرحمن في حفظ القرآن ص 16.
القرآن.
8- اشترط مع نفسك أنه عند الإخلال بهذا الورد تقوم بمعاقبتها بشي ء مباح كالصيام و الصدقة و نحوهما مع القيام به أيضا.
9- يمكنك أن تلتزم بالقراءة في مصحف واحد، أي طبعة واحدة لا تقرأ في غيرها من طبعات، و ذلك حتى تتذكر موضع الآيات.
10- احرص على أن تقرأ بما تحفظه في الصلاة، خاصة السنن، و يا حبذا صلاة الجماعة، خاصة صلاة الصبح، و يا حبذا أيضا صلاة التراويح، مع مراعاة هدي النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة و مقدار قراءته صلى الله عليه و سلم فيها.
11- داوم على أذكار الصباح و المساء، و النوم، و أيضا المداومة على الأحراز التي تحفظك بإذن اللّه تعالى من الشيطان (1)، فإن الذكر عدو الشيطان، قال اللّه تعالى: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (2).
قال العلماء في بيان ما يدعو الشيطان إليه ابن آدم و يوسوس له:
و ينحصر ذلك في ست مراتب:
المرتبة الأولى: مرتبة الكفر و الشرك، و معاداة اللّه تعالى و رسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه و استراح من تعبه معه.
المرتبة الثانية: مرتبة البدعة، و هي أحب إليه من الفسوق و المعاصي لأن ضررها في الدين، فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة.
المرتبة الثالثة: و هي الكبائر على اختلاف أنواعها. فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الرابعة.0.
ص: 57
1- يمكن النظر في هذا إلى كتاب ففروا إلى اللّه للأستاذ أبي ذر القلموني.
2- سورة المائدة، الآية: 90.
المرتبة الرابعة: و هي الصغائر، التي إذا اجتمعت ربما أهلكت صاحبها، فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الخامسة.
المرتبة الخامسة: و هي اشتغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها و لا عقاب، بل عقابها فوات الثواب الذي فات عليه باشتغاله بها، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة السادسة.
المرتبة السادسة: و هو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه (1).
و من الأحراز من الشيطان، و التي هي من الأهمية بمكان ما أخرجه أبو داود من حديث عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم: أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ باللّه العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم» قال: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم». و قد صحح الألباني- رحمه اللّه تعالى- هذا الحديث في صحيح الجامع.
12- في بداية الحفظ لا بدّ من المراجعة على يد مجيد لتلاوة القرآن.
13- لا تبدأ في حفظ القرآن إلا بعد إجادة تلاوته.
14- لا تتخلص عن مجالس العلماء، خاصة مجالس القرآن إلا لعذر، و مقياس هذا العذر ما ترى لو و عدت في هذا المجلس بألف دينار هل كنت ستتخلف عنه؟ البعض لو دعى إلى نسيكة (عقيقة) أو وليمة لبى مسرعا، و إذا مر بمجلس علم ولى مدبرا! يا قوم: كما يقول الحسن البصري: الدنيا ظلام إلا مجالس العلماء.
15- يمكنك أن تأتي بكراسة من الورق الأبيض، في نفس طبعة المصحف الذي تحفظ منه، ثم ترقم صفحاتها بنفس ترقيم المصحف، مع قيامك برسم المستطيل الداخلي في كل ورقة، بنفس مقاس تلك الطبعة، ثم بعد ذلك-.
ص: 58
1- هذه المراتب و هذا المبحث من كتاب عون الرحمن نقلا عن آكام المرجان و مدارج السالكين لابن القيم- رحمه اللّه-.
تقوم بكتابة الكلمات التي أنسيتها، أو التبس عليك حفظها، بخط واضح كاللون الأحمر مثلا، مع تركك باقي الصفحة دون كتابة، فإذا أردت مراجعة سورة ما نظرت إلى تلك الكراسة، بحيث توضع الكلمات المراد كتابتها في الكراسة في نفس مكانها من المصحف.
16- عليك بالصاحب الذي يساعد على ذكر اللّه، فإن بعض الأصحاب إذا دعوته لتلاوة القرآن أخبرك بأنه يريد الانصراف لأمر ما، و لو أنك قد استرسلت معه في حديث غيره ما أخبرك بالانصراف، فاظفر بالصديق الذي يعينك على تلاوة القرآن فإنه كنز نفيس.
17- إذا صليت وراء إمام و كنت تحفظ الآيات التي يتلوها في الصلاة فقف مستمعا لا مصححا، فإذا أحسست أن الآيات قد تلتبس عليه، فادع اللّه له بقلبك دون تحريك الشفتين، ثم بعد ذلك كما قيل: «إن استطعمك الإمام فأطعمه». و لتكن نيتك عند التصحيح إجلال كلام اللّه تعالى و حفظه، و إلا كما جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد- رحمه اللّه- مرفوعا: «من تكلم رياء فهو في سخط اللّه حتى يسكت».
18- اعلم- أيدك اللّه بنصره- أن بداية العلم هو حفظ القرآن، و كل آية تحفظها باب مفتوح إلى اللّه تعالى، و كل آية لا تحفظها أو أنسيتها باب مغلق، حال بينك و بين ربك، و اعلم أن المسلم لو عرض عليه مل ء الأرض ذهبا لا يساوي نسيانه لأقصر سورة في القرآن، بل لا يساوي نسيانه حرفا من كتاب اللّه تعالى، فينبغي إذا أن يكون حرصك على ما لا تحفظه من القرآن أكثر من حرصك على أقصر سورة في القرآن.
تنبيه: كما قال العلماء: يقال أقصر سورة و لا يقال أصغر سورة، حيث لا صغير في القرآن الكريم.
19- المحافظة على الوضوء مع إحسانه، و معنى الإحسان هنا اتباع هدي النبي صلى الله عليه و سلم في الوضوء، خاصة عدم الاعتداء فيه، جاء في هامش كتاب
ص: 59
زاد المعاد لابن القيم- رحمه اللّه- ج 1 ص 209 بتحقيق الأرناءوط أثابه اللّه تعالى تعليقا على قول ابن القيم- رحمه اللّه-: «و كان صلى الله عليه و سلم يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية و صلاها بسورة (ق) و صلاها بسورة الروم ..».
قال الأرناءوط أثابه اللّه: روى الإمام أحمد 3/ 472، و النسائي 2/ 156 عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها (الروم) فأوهم، فلما انصرف قال: «إنه يلبس علينا القرآن، فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد منكم الصلاة معنا، فليحسن الوضوء» و سنده حسن و قال الحافظ ابن كثير- رحمه اللّه- بعد أن ذكره في تفسيره في آخر سورة الروم: و هذا إسناد حسن، و متن حسن، و فيه سر عجيب و نبأ غريب، و هو أنه صلى الله عليه و سلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام.
20- المحافظة على الاستغفار و الإكثار منه، فإن نسيان القرآن من الذنوب، جاء في رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة، أثابه اللّه تعالى: [ص 154- 156]: «قال عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحتسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. و جاء في (طبقات الحنفية) لعلي القارئ [2: 487]: «و كان الإمام أبو حنيفة- رحمه اللّه تعالى و رضي عنه-: إذا أشكلت عليه مسألة قال لأصحابه: ما هذا إلا لذنب أحدثته! و كان يستغفر، و ربما قام و صلى، فتنكشف له المسألة.
و يقول: رجوت أني تيب عليّ. فبلغ ذلك الفضيل بن عياض، فبكى بكاء شديدا ثم قال: «ذلك لقلة ذنبه، فأما غيره فلا ينتبه لهذا» و جاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر، في ترجمة وكيع بن الجراح الكوفي [11: 129] و هو أحد الأئمة الأعلام الحفاظ، و قد كان الناس يحفظون تكلفا، و يحفظ هو طبعا، قال علي ابن خثرم: رأيت وكيعا و ما رأيت بيده كتابا قط، إنما هو يحفظه، فسألته عن دواء الحفظ؟ فقال: «ترك المعاصي، ما جربت مثله
ص: 60
للحفظ».
و قد استوفى الشيخ ابن القيم- رحمه اللّه- في كتابه (الفوائد) و كتابه (الجواب الكافي) بيان أضرار الذنوب و المعاصي استيفاء جامعا، و قابل بين آثار فعل الذنوب و آثار تركها مقابلة صادقة دقيقة، تدفع بكل ذي لب و عقل إلى ترك الذنوب و البعد عن أسبابها، و إلى التحلي بالطاعات و ما يبعث عليها.
قال رحمه اللّه في كتابه الفوائد: «الذنوب جراحات، و رب جرح وقع في مقتل!! و ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب و البعد عن اللّه، و أبعد القلوب من اللّه القلب القاسي! و إذا قسا القلب قحطت العين، و قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل، و النوم، و الكلام، و المحافظة» انتهى من رسالة المسترشدين.
و مما ذكره ابن القيم- رحمه اللّه- في كتابه القيم (الجواب الكافي):
و للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة، المضرة بالقلب و البدن في الدنيا و الآخرة ما لا يعلمه إلا اللّه، فمنها: حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه اللّه في القلب، و المعصية تطفئ ذلك النور، و لما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك و قرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته، و توقد ذكائه، و كمال فهمه، فقال:
إني أرى اللّه قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية.
و قال الشافعي:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي
و قال: اعلم بأن العلم فضل و فضل اللّه لا يؤتاه عاصي
قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء، فقال له: لا تعصه بالنهار و هو يقيمك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يديه بالليل من أعظم الشرف، و العاصي لا يستحق هذا الشرف.
و قد ذكر ابن كثير- رحمه اللّه- في تفسيره لقول اللّه سبحانه و تعالى في سورة الشورى: وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ
ص: 61
كَثِيرٍ.
عن الضحاك قال: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ الآية ثم قال الضحاك: و أي مصيبة أكبر من نسيان القرآن.
و مما جاء في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه-، نقلا عن مقدمة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، «قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه، و سيلان ذهنه، و قوة حافظته، و سرعة إدراكه، و اتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق، و قال:
سمعت في البلاد بصبي يقال له: أحمد بن تيمية، و أنه سريع الحفظ، و قد جئت قاصدا لعلي أراه، فقال له خياط: هذه طريق كتابه فجلس الشيخ الحلبي قليلا، فمر صبيان، فقال الخياط: هذا الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية، فناداه الشيخ فجاء إليه فتناول اللوح منه، فنظر فيه ثم قال له: امسح يا ولدي هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه، ففعل، فأملى عليه من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثا، و قال له: اقرأ هذا، فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه، و قال: أسمعه علي، فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع، فقال له: يا ولدي، امسح هذا. ففعل، فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ثم قال: اقرأ هذا، فنظر فيه كما فعل أول مرة، ثم أسمعه إياه كالأول، فقام الشيخ و هو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم ير مثله».
و مما جاء في مقدمة فتاويه- رحمه اللّه- و التي بلغت سبعة و ثلاثين جزءا:
«و من الغريب أن هذه المسائل كان يكتبها «شيخ الإسلام»- قدس اللّه روحه- أو يمليها من غير مراجعة كتاب من الكتب، و هي من الآيات البينات و البراهين الواضحات على أن هذا الرجل من أكبر آيات اللّه في خلقه، أيد بها
ص: 62
الذي قال فيه: (يهدي للتي هي أقوم) و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم، و ما كان عليه السلف الصالح من فهمها، و الاعتصام بها».
و لقد قال عنه الحافظ المزي: ما رأيت مثله، و ما رأى هو مثل نفسه، و لا رأيت أحدا أعلم بكتاب اللّه و سنة رسوله و لا أتبع لها منه.
و قال رئيس القضاة ابن الحريري: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟! و قال فيه شيخ النحاة أبو حيان لما اجتمع به: «ما رأت عيناي مثله».
و قال الحافظ الزملكاني: لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولي في حسن التصنيف، و جودة العبارة و الترتيب، و التقسيم، و التبيين، و قد ألان اللّه له العلوم، كما ألان لداود الحديد، كان إذا سئل عن فن من العلوم ظن الرائي و السامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن.
تنبيه: من أقيم الكتب التي تتكلم عن علوم القرآن: الأجزاء من الثاني عشر إلى السابع عشر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه-.
21- احذر الغرور، و تعلم القرآن، و تعلم للقرآن السكينة و الوقار، قال اللّه تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (1).
قال الألوسي- رحمه اللّه-: و كان الظاهر أن يقال: (ليعلموا) بدل (لينذروا) و (يفقهون) بدل (يحذرون) لكنه اختير ما في النظم الجليل، للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المعلم: الإرشاد و الإنذار، و غرض المتعلم:
اكتساب الخشية لا الاستكبار.
و جاء في هامش «رسالة المسترشدين» قال المحقق أثابه اللّه: «و قد لزم الإمام أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه شيخه هشيم بن بشير الواسطي خمس سنين، قال: و ما2.
ص: 63
1- سورة التوبة، الآية: 122.
سألته عن شي ء هيبة له إلا مرتين. كما في كتاب العلل للإمام أحمد (1/ 145).
و جاء في الجامع الصغير للسيوطي عن النبي صلى الله عليه و سلم قوله: «تعلموا العلم، و تعلموا للعلم السكينة و الوقار، و تواضعوا لمن تعلمون منه»، رواه عن أبي هريرة: الطبراني في الأوسط، و ابن عدي في الكامل، بإسناد ضعيف.
قال العلامة المناوي «في فيض القدير (3/ 253) في شرح قوله صلى الله عليه و سلم:
«تواضعوا لمن تعلمون منه». «فإن العلم لا ينال إلا بالتواضع، و إلقاء السمع، و تواضع الطالب لشيخه رفعة، و ذله له عز، و خضوعه له فخر، و أخذ الحبر- أي العالم الإمام- عبد اللّه بن عباس- رضي اللّه عنهما- مع جلالته و قرابته لرسول اللّه صلى الله عليه و سلم بركاب زيد بن ثابت و قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فقبل زيد يد ابن عباس و قال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا.
و قال السليمي: ما كان إنسان يجترئ على ابن المسيب ليسأله حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير.
و قال الشافعي: كنت أتصفح الورق بين يدي مالك برفق لئلا يسمع وقعها.
و قال الربيع- تلميذ الإمام الشافعي-: و اللّه ما اجترأت أن أشرب الماء و الشافعي ينظر.
و قال محقق رسالة المسترشدين أيضا: «و في مناقب الإمام أبي حنيفة للموفق الخوارزمي (2/ 7): روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حمّاد إجلالا له. و كان بين داري و داره سبع سكك، و ما صليت صلاة منذ مات حمّاد إلا استغفرت له مع والدي، و إني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما.
و قال أبو يوسف- تلميذ الإمام أبي حنيفة-: إني لأدعو اللّه لأبي حنيفة قبل أبوي، و لقد سمعت أبا حنيفة يقول: إني لأدعو اللّه لحماد مع أبوي.
ص: 64
فوائد تتعلق بهذه المباحث:
1- تحزيب القرآن
1- روى أبو داود في سننه (باب تحزيب القرآن) قال أوس: سألت أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث، و خمس، و سبع، و تسع، و إحدى عشرة، و ثلاث عشرة، و حزب المفصل وحده، بيانه:
«ثلاث»: البقرة، و آل عمران، و النساء.
و «خمس»: المائدة، و الأنعام، و الأعراف، و الأنفال، و براءة.
و «سبع»: يونس، و هود، و يوسف، و الرعد، و إبراهيم، و الحجر، و النحل.
و «تسع»: سبحان، و الكهف، و مريم، و طه، و الأنبياء، و الحج، و المؤمنون، و النور، و الفرقان.
و «إحدى عشرة»: الشعراء، و النمل، و القصص، و العنكبوت، و الروم، و لقمان، و السجدة، و الأحزاب، و سبأ، و فاطر، و يس.
و «ثلاث عشرة»: الصافات و ص، و الزمر، و غافر، و حم السجدة، و حم عسق، و الزخرف، و الدخان، و الجاثية، و الأحقاف، و القتال، و الفتح، و الحجرات.
و «الحزب المفصل»: كما قال الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن كثير- رحمه اللّه- في أول تفسيره لسورة ق- بعد أن ذكر ذلك-: فتعين أن أوله (أي المفصل) سورة ق.
2- عدد سور القرآن:
و عدد سور القرآن مائة و أربع عشرة سورة (1)، أولها سورة الفاتحة و آخرها سورة الناس، و ذلك ما اتفق عليه جمهور الصحابة في تدوينهم للقرآن، و أثبتوه في المصاحف العثمانية، و هو الذي بأيدي المسلمين و في
ص: 65
1- البيان في علوم القرآن ص 135.
صدورهم منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا و حتى تقوم الساعة.
و لا التفات لما ورد عن مجاهد من أن عدد سور القرآن مائة و ثلاث عشرة سورة، معتبرا الأنفال و التوبة سورة واحدة، لعدم وجود البسملة في أول براءة، لأن ذلك مردود بما ثبت من أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم سمى كلّا منهما بذاتها، و باتفاق الصحابة على العدد الأول، و إثباته في مصحف عثمان رضي الله عنه.
أو بما ورد من أن عدد السور في مصحف ابن مسعود مائة و اثنتا عشرة سورة، لأنه كما قال: لم يكتب المعوذتين في مصحفه.
أو بما ورد من أن مصحف أبي بن كعب به مائة و ست عشرة سورة، لأنه كان يكتب فيه سورتي الخلع و الحفد، لأن كلّا منهما رجع إلى إجماع الصحابة، و وردت قراءة كل منهما لنا من عدة طرق على ما جاء في مصحف عثمان رضي الله عنه.
3- أسامي سور القرآن:
قد يكون للسورة اسم واحد، و هو كثير، و ذلك مثل سورة النساء، و الأعراف، و الأنعام، و مريم، و طه، و الشورى، و المدثر، و غير ذلك.
و قد يكون لها اسمان، و ذلك مثل سورة البقرة، فإنه يقال لها (فسطاط القرآن) لعظمتها و بهائها، و (آل عمران) يقال: اسمها في التوراة (طيبة) و (النحل) تسمى سورة النعيم، لما عدد اللّه فيها من النعم على عباده.
و (الجاثية) تسمى الشريعة، و سورة (محمد) صلى الله عليه و سلم و تسمى القتال.
و قد يكون لها ثلاث أسماء، و ذلك مثل سورة (المائدة) و تسمى العقود و المنقذة. و سورة (غافر) و تسمى الطول و المؤمن.
و قد يكون للسورة أكثر من ذلك، كسورة (براءة) تسمى أيضا التوبة، و الفاضحة، و البحوث بفتح الباء، و قد أنهى السيوطي أسماءها إلى عشرة أسماء، و سورة الفاتحة تسمى أيضا فاتحة الكتاب، و أم الكتاب، و أم القرآن، و السبع المثاني، و الشافية، و الكافية، و الأساس.
ص: 66
و قد أنهى السيوطي أسماءها إلى خمس و عشرين اسما إلى غير ذلك من السور التي تسمى بأكثر من اسم واحد.
و كما سميت السورة الواحدة بعدة أسماء سميت سور عديدة باسم واحد، و ذلك كالسور المسماة ب (الم) و (حم) و ذلك على القول بأن فواتح السور أسماء لها، و تكون هذه الأسماء من قبيل المشترك اللفظي، و التمييز بين السور يكون بقرينة ضميمة إليها، فيقال: (الم) البقرة، (الم) آل عمران، و (الم) السجدة، و يقال (حم) غافر و (حم) السجدة و هكذا.
4- هل تسمية السور توقيفية أم اجتهادية؟
قيل: إنها توقيفية، و عليه فنقف عند الحد الوارد فيها.
و قيل إنها اجتهادية، و على هذا فلا يعدم الناظر أن يستنتج للسورة الواحدة أسماء أخرى غير الواردة فيها. و الظاهر الأول.
قال السيوطي: و قد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث و الآثار، و لو لا خشية الإطالة لبينت ذلك (1).
و مما يدل لذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان المشركون يقولون: سورة البقرة و سورة العنكبوت يستهزءون بها، فنزل قول اللّه تعالى إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (2).
و قد ذكر الدكتور السيد إسماعيل علي الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة أنه: بناء على هذا يكون التوقيف أعم من أن يكون عن النبي صلى الله عليه و سلم، أو عن أصحابه الذين شهدوا الوحي و التنزيل.
و قد ذكر بعضهم أن يقال سورة كذا لما رواه الطبراني و البيهقي عن أنس مرفوعا: «لا تقولوا سورة البقرة و لا سورة آل عمران و لا سورة
ص: 67
1- انظر البيان في علوم القرآن ص 137.
2- سورة الحجر، الآية: 95.
النساء، و كذا القرآن كله، و لكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة و التي يذكر فيها آل عمران، و كذا القرآن كله».
قال السيوطي: و إسناد الحديث ضعيف، بل ادعى ابن الجوزي أنه موضوع.
و قال البيهقي: إنما يعرف موقوفا على ابن عمر، ثم أخرجه عنه بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
و من ثم لم يكرهه الجمهور.
و للزركشي في هذا المقام كلام طويل حيث قال في البرهان ما نصه:
«ينبغي البحث عن تعداد الأساس، هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟
فإن كان الثاني فلم يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسماء لها و هو بعيد. قال: و ينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت به، و لا شك أن العرب تراعي في كثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشي ء من خلق أو صفة تخصه، أو تكون معه أحكم، أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى، و يسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها.
و على ذلك جرت أسماء سور القرآن كتسمية سورة البقرة بهذا الإسم لقرينة قصة البقرة المذكورة فيها، و عجيب الحكمة فيها. و سميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها شي ء كثير من أحكام النساء.
و تسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها، و إن كان ورد لفظ الأنعام في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى: وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً إلى قوله: أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ الآية: (46).
لم يرد في غيرها، كما ورد ذكر النساء في سورة، إلا أن ما تكرر و بسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء. و كذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها فسميت بما يخصها.
ص: 68
قال: فإن قيل قد ورد في سورة هود ذكر نوح، و صالح و إبراهيم، و لوط، و شعيب، و موسى، فلم خصت باسم هود وحده؟ مع أن قصة نوح فيها أوعب و أطول؟ قيل: تكررت هذه القصص في سورة الأعراف، و سورة هود، و الشعراء بأوعب مما وردت في غيرها، و لم يتكرر في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود كتكرره في سورته، فإنه تكرر فيها في أربعة مواضع و التكرار من أقوى الأسباب التي ذكرنا.
قال: فإن قيل: فقد تكرر اسم نوح فيها في ستة مواضع؟ قيل: لما أفردت لذكر نوح و قصته مع قومه سورة برأسها، فلم يقع فيها غير ذلك كانت أولى بأن تسمى باسمه من سورة تضمنت قصته و قصة غيره.
قال السيوطي تعقيبا على هذا الكلام ما نصه: و لك أن تسأل فتقول:
قد سميت سور جرت فيها قصص أنبياء بأسمائهم كسورة نوح، و سورة هود، و سورة إبراهيم، و سورة يوسف، و سورة محمد صلى الله عليه و سلم، و سورة مريم، و سورة لقمان، و سورة المؤمنون، و قصة أقوام كذلك كسورة بني إسرائيل، و سورة أصحاب الكهف، و سورة الحجر، و سورة سبأ، و سورة الملائكة، و سورة الجن، و سورة المنافقين، و سورة المطففين، و مع هذا كله لم يفرد لموسى سورة تسمى به مع كثرة ذكره في القرآن حتى قال بعضهم: كاد القرآن أن يكون كله لموسى، و كان أولى سورة أن تسمى به سورة (طه)، أو سورة (القصص)، أو سورة (الأعراف)، لبسط قصته في الثلاث ما لم يبسط في غيرها.
و كذلك قصة آدم ذكرت في عدد سور و لم تسم به سورة كأنه اكتفاء بسورة الإنسان، و كذلك قصة الذبيح من بدائع القصص، و لم تسم به سورة الصافات، و قصة داود ذكرت في سورة (ص) و لم تسم به، فانظر في حكمة ذلك.
ثم قال السيوطي: على أني رأيت في (جمال القراء) للسخاوي أن سورة طه تسمى سورة (الكليم) و سماها الهذلي في كامله (سورة موسى) و أن سورة
ص: 69
(ص) تسمى سورة (داود) و رأيت في كلام الجعبري أن سورة (الصافات) تسمى سورة (الذبيح) و ذلك يحتاج إلى مستند من الأثر.
5- أقسام سور القرآن:
اشارة
قسم العلماء سور القرآن الكريم من حيث الطول و القصر إلى أربعة أقسام هي:
القسم الأول:
(الطوال)، و هي سبع سور: البقرة، و آل عمران، و النساء، و المائدة، و الأنعام، و الأعراف، ثم الأنفال مع براءة لعدم الفصل بينهما بالبسملة، و قيل: براءة بمفردها، و قيل: السابعة هي يونس، و لكن لا وجه لهذا القول، لأن براءة أطول منها بكثير.
القسم الثاني:
(المئون) جمع مائة، و هي السور التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربها.
القسم الثالث:
(المثاني) و هي السور التي تلي المئين في عدد الآيات بأن تكون أقل من مائة آية، و سميت مثاني، لأنها تثنى و تكرر أكثر من غيرها.
القسم الرابع:
(المفصل)، و هو ما ولي المثاني من قصار السور، و سمي بذلك لكثرة الفواصل التي بين السور بالبسملة، و قيل لقلة المنسوخ فيه، و قد اختلف في أوله على أقوال أوصلها السيوطي إلى اثني عشر قولا فقيل: أوله (ق) و قيل: (الحجرات) و هو الذي صححه النووي، و المفصل ثلاثة أقسام هي:
1- طوالة، و هي من سورة (الحجرات) إلى سورة (البروج).
2- أوساطه، من سورة (الطارق) إلى سورة (لم يكن).
3- قصاره: من سورة (الزلزلة) إلى آخر القرآن.
ص: 70
كيفية تلاوة القرآن الكريم
اشارة
و ما الواجب على مبتدئ تعلم التجويد أن يتعلمه أولا
أ- كيفية تلاوة القرآن الكريم:
ذكر الشيخ محمود الحصري (1) في كتابه (مع القرآن الكريم) ما نصه:
اتفق علماء القراءة، و أئمة الأداء، على أن لتلاوة القرآن الكريم كيفية مخصوصة، يجب على القارئ شرعا أن يلاحظها أثناء تلاوته، ليحرز الأجر الذي وعد اللّه به القارئين. فإذا أهملها أو قصر في مراعاتها، كان من الآثمين.
و هذه الكيفية هي تجويد كلماته، و تقويم حروفه، و تحسين أدائه، بإعطاء كل حرف حقه، و منحه مستحقه، من الإجادة، و الإتقان، و الترتيل، و الإحسان، و لا يكون ذلك إلا بتصحيح إخراج كل حرف من مخرجه الأصلي المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه، و توفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسة، مع تيسير النطق به على حال صفته، و كمال هيئته، من غير تشدق و لا إسراف، و لا تصنّع و لا تعسّف، و مع العناية بإبانة الحروف، و تمييز بعضها من بعض، و إظهار التشديدات و توفية الغنات، و إتمام الحركات، و مع تفخيم ما يجب تفخيمه، و ترقيق ما يجب ترقيقه، و قصر ما ينبغي قصره، و مد ما يتعين مده. و مع ملاحظة الجائز من الوقف و الممنوع منها، فيوقف على ما يصح الوقف عليه، و يوصل ما لا يصح الوقف عليه، إلى غير ذلك من الأحكام و القواعد التي وضعها أئمة القرآن.
قال الإمام المحقق ابن الجزري في كتابه (النشر): «و لا شك أن الأمة- كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن و إقامة حدوده- متعبدون بتصحيح ألفاظه، و إقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة، المتصلة بالحضرة
ص: 71
1- هو فضيلة الشيخ محمود الحصري شيخ عموم المقارئ بالجمهورية العربية المتحدة قديما و مؤلف (معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف و الابتداء).
النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها، و لا العدول عنها إلى غيرها».
و تلك الكيفية هي التي نزل بها القرآن الكريم، و هي المرادة من الترتيل الذي أمر اللّه به نبيه محمدا صلى الله عليه و سلم في قوله تعالى: وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.
قال ابن عباس رضي الله عنه: أي بيّنه.
و قال مجاهد: تأنّ فيه.
و قال الضحاك انبذه حرفا حرفا، و افصل الحرف من الحرف الذي بعده.
و جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: الترتيل تجويد الحروف، و معرفة الوقوف.
و قال بعضهم: أي تثبت في قراءتك و تمهل فيها.
و لم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتماما به و تعظيما له، ليكون ذلك عونا على تدبر القرآن و تفهمه.
و هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه و سلم، قال: «إن اللّه يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه.
و عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة الرسول صلى الله عليه و سلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. أخرجه الترمذي.
و قالت عائشة رضي اللّه عنها: كان رسول اللّه صلى الله عليه و سلم يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها.
و سئل أنس بن مالك عن قراءة رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فقال: كانت مدّا، ثم قرأ أنس بسم اللّه الرحمن الرحيم، يمد اللّه، و يمد الرحمن، و يمد الرحيم.
و عن أم سلمة أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: كان يقطع قراءته فيقول: الحمد للّه رب العالمين، ثم يقف، الرحمن الرحيم، ثم يقف، مالك يوم الدين، و هكذا.
رواه الترمذي و أبو داود.
قال القرطبي: «قال علماؤنا: قول أم سلمة: «كان يقطع قراءته» يدخل فيه جميع ما كان يقرؤه من القرآن، و إنما ذكرت فاتحة الكتاب لتبين صفة
ص: 72
التقطيع، أو لأنها أم القرآن فيغني ذكرها عن ذكر ما بعدها، فالتقطيع عام لجميع القراءة لظاهر الحديث».
و ذكر الزهري أن قراءة الرسول صلى الله عليه و سلم: كانت آية آية. و هذا هو الأفضل، و هو الوقوف على رءوس الآي و إن تعلقت بما بعدها.
و ذهب بعضهم إلى أن الوقوف على رءوس الآي أفضل ما لم تتعلق الآية بما بعدها، فإن تعلقت بما بعدها كان الوقف على ما يتم به الكلام أفضل، و لكن اتباع هدى الرسول و سنته أولى، و ممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان و رجح الوقف على رءوس الآي و إن تعلقت بما بعدها.
و قد اختلف العلماء: هل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة، أو السرعة مع كثرتها؟
فذهب فريق إلى أن الترتيل و التدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها.
و هذا مذهب ابن عباس و ابن مسعود و غيرهما، و قد احتجوا لهذا المذهب بأدلة:
الأول: أن المقصود من قراءة القرآن فهمه و تدبره، و التفقه فيه و العمل به، و ما تلاوته و حفظه إلا وسيلة إلى معانيه، فقد قال بعض السلف: نزول القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، و لهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه، و إن لم يحفظوه عن ظهر قلب. و أما من حفظه و لم يفهمه و لم يعمل به فليس من أهله و إن جود كلماته و أتقن حروفه.
الثاني: أن الإيمان هو أفضل الأعمال على الإطلاق، و فهم القرآن و تدبره هو الذي يثمر الإيمان، و أما مجرد التلاوة من غير فهم و لا تدبر فيفعلها البر و الفاجر، و المؤمن و المنافق. فمن أوتي تدبرا و فهما في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة و سرعتها بلا تدبر.
الثالث: أنه كان من هدي الرسول صلى الله عليه و سلم أنه كان يرتل السورة حتى
ص: 73
تكون أطول من أطول منها، و ثبت عنه أنه قام بآية واحدة في الليل، و أخذ يرددها حتى الصباح. و هي إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رواه النسائي و ابن ماجة.
و قال أبو حمزة لابن عباس: إني رجل سريع القراءة و ربما قرأت القرآن كله مرة في الليلة، فقال له ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أرتلها و أتدبرها أحب إلي من أن أفعل الذي تفعل، فإن كنت فاعلا فاقرأ قراءة تسمعها أذنك و يعيها قلبك. رواه البخاري.
و قال ابن مسعود: لا تهذوا بالقرآن هذ الشعر، و لا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه، و حركوا به القلوب، و لا يكن هم أحدكم آخر السورة.
و الهذ: الإسراع، أي لا تسرعوا في القراءة إسراعكم بالشعر و الدقل بفتح الدال و القاف: أردأ التمر.
و المعنى النهي عن عدم العناية بإتقان القراءة، بالإسراع فيها و عدم رعاية حدودها.
و قال ابن مسعود أيضا: و إذا سمعت اللّه تعالى يقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. فأصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه.
و جاء رجل فقال له: إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: أ هذّا كهذّ الشعر؟
و سئل مجاهد عن رجلين أحدهما قرأ البقرة و الآخر قرأ البقرة و آل عمران في الصلاة، و ركوعهما و سجودهما واحد. فقال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل.
و عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: «لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح سورتي الزلزلة و القارعة، لا أزيد عليهما، و أتردد فيهما و أتفكر أحب إلي من أن أهذّ القرآن هذّا و أنثره نثرا».
و عن عائشة رضي الله عنه أنه ذكر لها أن أناسا يقرءون القرآن في الليلة مرة أو
ص: 74
مرتين فقالت: أولئك قوم قرءوا و لم يقرءوا، كنت أقوم مع الرسول صلى الله عليه و سلم ليلة التمام، فكان يقرأ البقرة و آل عمران و النساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا اللّه و استعاذ، و لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا اللّه و رغب إليه. رواه أحمد.
قال ابن كثير: «و في الحديث دليل على استحباب ترتيل القراءة و الترسل فيها، من غير هذرمة و لا بسرعة مفرطة، بل بتأمل و تفكر، قال تعالى: كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ.
و الهذرمة: الإسراع في القراءة.
و قال الغزالي: إن الترتيل مستحب، لا لمجرد التدبر فإن الأعجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له في القراءة الترتيل و التؤدة، بل لأن ذلك أقرب إلى توقير القرآن و احترامه و أشد تأثيرا في القلب من السرعة و الاستعجال».
و ذهب فريق منهم- و منهم أصحاب الشافعي- إلى أن كثرة القراءة أفضل، و احتجوا لذلك بحديث ابن مسعود: «من قرأ حرفا من كتاب اللّه فله حسنة و الحسنة بعشر أمثالها لا أقول (الم) حرف و لكن ألف حرف، و لام حرف، و ميم حرف» أخرجه الترمذي.
قالوا: و لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن في ركعة و ذكروا آثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة.
و قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: «و الصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل و التدبر أجل و أرفع قدرا، و ثواب كثرة القراءة أكثر عددا.
فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة جدا أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا. و الثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم، أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة».
ص: 75
ب- الواجب على مبتدئ تعلم التجويد أن يتعلمه أولا:
اشارة
من الواجب المتحتم على كل مبتدئ في تعلم أحكام التجويد أن يتعلم أمورا مرتبة لا بد من أن يبتدئ بها و هي:
أولا: تعلم مخارج الحروف و صفاتها.
و تعلم مخارج الحروف و صفاتها أشار إليها الإمام ابن الجزري- رحمه اللّه تعالى- في الجزرية و هي قصيدة تتكون من (106) أبيات تناول فيها الناظم صفات الحروف و مخارجها بعد المقدمة مباشرة فقال:
و بعد إن هذه المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه
إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا
مخارج الحروف و الصفات ليلفظوا بأفصح اللغات
قد ذكرت في كتابي الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم معنى هذه الأبيات الثلاثة فقلت بعون اللّه تعالى:
(و بعد) (1): أي و بعد ما تقدم من الحمد للّه و الصلاة، و هذه الكلمة (و بعد) يؤتى بها دائما للانتقال من غرض أو أسلوب إلى آخر، و يستحب الإتيان بها في الخطب اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم، (و هذه) إشارة إلى القصيدة التي بين أيدينا و هي أرجوزة جميلة، (و مقدمة) و هي طائفة من العلم كمقدمة الجيش من قدم بمعنى: تقدم بكسر الدال و منه قول اللّه تعالى: لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ أي لا تتقدموا و قيل في الآية: إن المفعول مقدر أي لا تقدموا أمرا، و يجوز فتح دال مقدمة و هي لغة قليلة كمقدمة الرحل، و المراد بها طائفة من مسائل علم القراءة ينبغي الاهتمام بها و الاعتناء بشأنها، و قد أشار المصنف بقوله: (فيما على قارئه أن يعلمه) أي بيان ما يجب على كل قارئ أن يتعلمه قبل البدء في تلقي القواعد الكلية و الجزئية في هذا العلم.
ص: 76
1- الوافي في ترتيل القرآن ص 68.
أي من الأمور الواجبة و المحتمة على كل قارئ قبل، و ربما يراد بكلام الناظم الوجوب الشرعي، أي يأثم من ترك علمه أو العلم به، و المقصود بهذا كله أنه لا بد قبل الشروع في تعلم القرآن لتجويده أن يعلم القارئ جيدا مخارج الحروف و صفاتها، و الوجوب الشرعي هنا ما يثاب على فعله، و يعاقب على تركه، و العرفي ما لا بد منه في فعله، و لا يستحسن تركه، و يجب هنا حمل كلام المصنف على المعنى الاصطلاحي، و هو لا ينافي الوجوب الشرعي و من الملاحظ هنا أن جميع ما في هذه المقدمة ليس من هذا القبيل إلا إذا حمل على وجوب الكفاية، فمن اتصف بالفصاحة كالعرب الفصحاء و غيرهم ممن رزقه اللّه تعالى القراءة بالسليقة دون تعلم الأحكام فلا شك أنه ليس معناه الواجب عند الفقهاء الذي يعاقب على تركه، و أما من لم يتصف بما ذكر فلا بد في حقه من التجويد و عليه يحمل كلام الناظم و يراد به الوجوب الشرعي (و مخارج الحروف) و هذا الكلام تكملة للكلام السابق، و كأن المصنف يريد أن يقول: من الواجب على كل قارئ قبل الشروع في قراءة و تعلم القرآن أن يعلم أولا مخارج الحروف بواسطة صوت و هو هواء يتموج بتصادم جسمين، و إذا اتبع طالب العلم ذلك و أخذ العلم بالأداء عن أفواه و أسماع المشايخ تكون النتيجة أن يلفظ بلغة فصيحة مليحة، و هنا يكون قادرا على تلقي القرآن، و الحروف المقصودة هي الحروف الهجائية، و هي تسعة و عشرون حرفا، و (ليلفظوا) أي لينطقوا بلغة فصيحة إذا عرف الطالب كيف يخرج الحرف من مخرجه و ما الصفة التي تصاحبه وقت خروجه استطاع أن ينطق بأفصح اللغات.
و أفصح اللغات لغة قريش، و هي أفصح من لغات سائر العرب العرباء، و هم قوم النبي صلى الله عليه و سلم لقول اللّه تعالى: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ، و لقوله صلى الله عليه و سلم: «أحب العربية لثلاث: لأني عربي، و القرآن عربي، و لسان أهل
ص: 77
الجنة في الجنة عربي» (1).
و الحديث أخرجه الطبراني و الحاكم و الضياء عن ابن عباس- رضي اللّه عنهما- و لا غرابة في ذلك فقد أنزل القرآن العظيم بلغة قريش، و قد يتولد الحرف من حرفين، و يتردد بين مخرجين بعضها فصيح و بعضها غير فصيح، و الوارد من الثاني في القرآن خمسة: الألف الممالة، و الهمزة المهملة، و اللام المفخمة، و الصاد كالزاي و النون المخفاة.
ثانيا: معرفة الوقف و الابتداء:
ذكر الشيخ الحصري- رحمه اللّه- في معالم الاهتداء ما نصه:
أجل! اعلم أن علم الوقف و الابتداء له أجل الأثر في حسن التلاوة و جودة القراءة.
إذ أنه يعرّف القارئ المواطن التي يتحتم الوقف عليها، و المواضع التي يحسن الوقف عندها، أو يقبح. و يقفه على الكلمات التي يتعين البدء بها، و الكلمات التي يحسن الابتداء بها أو يقبح.
و من ثم عني علماء الأمة سلفا و خلفا ببيان الوقف في القرآن- أعني المواضع التي يقف القارئ عندها- و بالحث على تعلمها و تعليمها فقد سئل علي رضي الله عنه عن معنى الترتيل في قوله تعالى: وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فقال:
الترتيل «تجويد الحروف، و معرفة الوقوف» قال الإمام المحقق ابن الجزري في كتابه «النشر في القراءات العشر».
ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلم الوقف و معرفته.
و أقول (2): وجه دلالة هذا الأثر على ما ذكر: أن قوله تعالى: وَ رَتِّلِ أمر و هو يقتضي الوجوب، و إذا كان المراد من الترتيل الذي أمر اللّه تعالى به،
ص: 78
1- حديث ضعيف.
2- القول للأستاذ الشيخ محمود الحصري- رحمه اللّه-.
أوجبه هو تجويد الحروف، و معرفة الوقوف كان كل منهما واجبا.
و صح عن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنهما- أنه قال:
«لقد عشنا برهة من الدهر و إن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، و تنزل السورة على النبي صلى الله عليه و سلم فنتعلم حلالها و حرامها، و أمرها و زجرها و ما ينبغي أن يوقف عنده منها».
و في هذا الأثر دليل واضح على أن الصحابة رضوان اللّه عليهم كانوا يتعلمون الوقف كما يتعلمون القرآن.
و قال أبو حاتم: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. و قال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف و الابتداء. إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل. و هذا الأثر يدل دلالة واضحة على تأكد معرفة الوقف و الابتداء في القرآن الكريم.
و قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: الوقف في الصدر الأول من الصحابة و التابعين و سائر العلماء مرغوب فيه من مشايخ القراءة و أئمة الأداء. مطلوب فيما سلق من الأعصار، وردت به الأخبار الثابتة و الآثار الصحيحة.
و قال الإمام الهذلي في كتابه الكامل: الوقف حلية التلاوة، و زينة القارئ. و بلاغ التالي، و فهم المستمع، و فخر العالم، و به يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين، و النقيضين المتنافيين، و الحكمين المتغايرين.
و لقد بلغ من عناية العلماء بمعرفة هذا النوع من العلم، و حضهم على تعلمه و تعليمه أن بعض أئمة هذا الشأن كان لا يجيز أحدا بالقراءة أو الإقراء- التعليم- إلا إذا عرف مواطن الوقف، و مواضع الابتداء.
و ممن كانوا يعنون بتعلم هذا العلم و تعليمه من أئمة القرآن- إمام القراء بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع. و كان من كبار التابعين و كان من أكابرهم علما و صلاحا و ورعا.
ص: 79
و الإمام نافع بن أبي نعيم و إمام القراءة و النحو أبو عمرو بن العلاء البصري، و الإمام يعقوب الحضرمي. و الإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي رضي الله عنهم أجمعين. و إنما عني العلماء بمعرفة الوقف و الابتداء، و حضوا الناس على تعلمهما و تعليمهما، و الاهتمام بشأنهما لما لهما من جليل الأثر في حسن التلاوة، و جودة القراءة، فكثيرا ما يكون في وقف القارئ على الكلمة تنبيه للسامع، و لفت لنظره إلى معنى الآية، و إدراك مغزاها، و يكون في وصل الكلمة بما بعدها إيهام معنى فاسد.
و من أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة يونس: وَ لا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فإن القارئ إذا وقف على قولهم فهم السامع أن معنى الآية نهيه صلى الله عليه و سلم عن الحزن على قول المشركين فيه ما لا يليق بمقامه الرفيع كما فهم أن قوله تعالى: فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً من قول اللّه تعالى تعليلا لنهيه صلى الله عليه و سلم عن الحزن.
أما إذا وصل القارئ قوله تعالى: (قولهم) بقوله: فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً فإن السامع يتبادر إلى ذهنه من أول وهلة أن هذا القول: إن العزة للّه جميعا- قول الكافرين.
و هذا باطل، فحينئذ يتعين الوقف على قولهم قصدا إلى إفادة المعنى الصحيح، و إلى دفع المعنى الفاسد القبيح.
قال بعض الأفاضل: إن الوقف قد يميز مذهب أهل السنة من مذهب المعتزلة. كالوقف على (و يختار) في قوله تعالى في سورة القصص: وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ فإن الوقف عليه يفيد مذهب أهل السنة و هو ثبوت الاختيار للّه وحده، و نفي الاختيار عن عباده. و على هذا تكون «ما» في ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ نافية بخلاف وصل و يختار بما بعده فإنه يفيد أن ما موصولة و أن للعباد الخيرة و أن اللّه تعالى يختار لعباده ما يختارون لأنفسهم، و هذا مذهب المعتزلة.
ص: 80
و مع حث العلماء سلفا و خلفا على العناية بهذا العلم. و كثرة حضهم على تعلمه و تعليمه، لم يتوفر على التأليف فيه- فيما نعلم- إلا نفر قليل.
و هم الإمام أبو عمرو و عثمان بن سعيد الداني، المتوفى سنة 444 هجرية، و كتابه يسمى «المكتفى» و الإمام أبو عبد اللّه محمد بن طيفور السّجاوندي و كتابه يسمى «الوقف و الابتداء». و العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني، و كتابه يسمى «المرشد».
ص: 81
نبذة مختصرة عن جمع القرآن
اشارة
جمع القرآن الكريم ثلاث مرات، و كانت الأولى (1) في عهد النبي صلى الله عليه و سلم، أما الثانية فكانت في أيام خليفته أبي بكر الصديق، أما الثلاثة فكانت أيام الصحابي الجليل، ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه و قد اختلفت طبيعة الجمع و دوافعه في كل مرة عن الأخرى.
أولا: الجمع في عهد النبي صلى الله عليه و سلم:
و قد تحقق ذلك بطريقتين:
الأولى: و تتمثل في حفظ النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته رضوان اللّه عليهم للقرآن الكريم، كان النبي صلى الله عليه و سلم حريصا على حفظه، يحاول اللحاق بما يتنزل عليه من وحي، فنزل قوله تعالى: لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ (2).
ذكر ابن عباس- رضي اللّه عنهما- «كان رسول اللّه صلى الله عليه و سلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك به لسانه و شفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه، فأنزل اللّه سبحانه لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قال: يقول: إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم نقرأه فَإِذا قَرَأْناهُ يقول: إذا أنزلناه عليه فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فاستمع له و أنصت ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ أن نبينه بلسانك، فكان رسول اللّه صلى الله عليه و سلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق، و في لفظ: استمع، فإذا ذهب قرأه كما وعد اللّه سبحانه. ورد في الصحيحين.
و كان صحابته على توزعهم في المواطن يحفظون كتاب اللّه، و عرف عن بعضهم أنه كان يحفظ القرآن كله كالخلفاء الأربعة و أمهات المؤمنين عائشة و حفصة و أم سلمة و أبي بن كعب، و زيد بن ثابت، و معاذ بن جبل، و عبد اللّه
ص: 82
1- وردت هذه الكلمات في محاضرات د/ عمر عبد الواحد الأستاذ بجامعة المنيا.
2- سورة القيامة، الآية: 16- 19.
ابن مسعود، و عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن عمرو، و عبد اللّه بن الزبير، و غيرهم كثيرون لا يحصون.
فعن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه و سلم إلى رجل منا يعلمه القرآن، و كان يسمع لمسجد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا.
فكان المسجد و كانت المنازل و البيوت مواضع مدارس القرآن الكريم و حفظه.
و عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال له: «لو رأيتني البارحة و أنا أستمع لقراءتك!! لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود» (1).
أما عن الطريقة الثانية بجمعه في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فهو الكتابة، فقد اتخذ النبي صلى الله عليه و سلم كتّابا للوحي، كان من بينهم: زيد بن ثابت و علي بن أبي طالب، و عثمان بن عفان، و عبد اللّه بن مسعود، و أنس بن مالك، و أبي بن كعب، و الزبير بن العوام، و عبد اللّه بن الأرقم، و عبد اللّه بن رواحة، و كان أكثرهم كتابة للوحي زيد بن ثابت، حتى لقد وصفه البخاري بلقب (كاتب النبي) و كانوا يكتبون فيما تتيحه لهم البيئة من إمكانيات و أدوات، كالعسب، و اللخاف، و قطع الأديم، و عظام الأكتاف و الأضلاع، و في الأقتاب، و في الرقاع (2).
و كان النبي صلى الله عليه و سلم يبين لهم مواضع الآيات و مكانها في السور على نحو ما كان يعلمه جبريل في معارضته في شهر رمضان من كل سنة بما نزل منك.
ص: 83
1- رواه البخاري، و زاد مسلم: فقلت: لو علمت و اللّه يا رسول اللّه أنك تسمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا.
2- العسب هو جمع عسيب و هو جريد النخيل، و اللخاف هو صفائح الحجارة، و قطع الأديم هي الجلد المدبوغ، و الأقتاب هي الخشب الذي تصنع منه الرحال، و الرقاع هو جمع رقعة من جلد أو ورق أو غير ذلك.
القرآن، فقد ذكر البخاري عن السيدة عائشة- رضي اللّه عنها- أنها قالت في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه و سلم: «أسر إليّ النبي صلى اللّه عليه و سلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة و أنه عارضني العام مرتين، و لا أراه إلا حضر أجلي».
أي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأمر أصحابه من كتبة الوحي بأن يكتبوا ما ينزل عليه من القرآن أولا بأول، و أنه كان يرتب لهم الآيات التي تنزل عليه منجمة في مواضعها من السور، فعن زيد بن ثابت أنه قال: كنا عند رسول اللّه صلى الله عليه و سلم نؤلف (1) القرآن من الرقاع- أي: أنهم كانوا يرتبون السور و الآيات المكتوبة في الرقاع بمقتضى إرشاد النبي صلى الله عليه و سلم و بتوقيف منه- و يذكر السيوطي نقلا عن بعض مصادره أن ترتيب الآيات في السور توقيفي بأمر الرسول صلى الله عليه و سلم و بعض المفسرين يفسر قوله تعالى: وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا بأنه قراءته على ترتيبه التوقيفي من غير تقديم و لا تأخير .. و يدل على قيام النبي صلى الله عليه و سلم بترتيب الآيات داخل السور، أنه كان يقرأ سورا كثيرة كاملة بترتيب آياتها في الصلاة أو في خطبة الجمعة.
أما عن ترتيب السور فالراجح أنه بتوقيف من الرسول صلى الله عليه و سلم فقد كان يقرأ في صلاته أحيانا بسور مرتبة، و هذا ما أوقفه عليه جبريل في معارضاته، و إن قال بعض العلماء أنه باجتهاد الصحابة و يستدلون على ذلك باختلاف ترتيب مصاحف الصحابة، فمصحف علي مرتب على حسب الترول، و مصحف ابن مسعود و أبي مبدوءان بالبقرة فالنساء ثم آل عمران، و إن كانت مصاحف فردية كتبها كل واحد منهم لنفسه، و على حسب سماعه من النبي صلى الله عليه و سلم.
ص: 84
1- و معنى التأليف هنا الجمع، أي يجمعونه.
ثانيا: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق:
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر- رحمه اللّه-. و قال علي رضي الله عنه: أبو بكر هو أول من جمع كتاب اللّه.
أما قصة جمعه فيذكرها زيد بن ثابت كاتب النبي صلى الله عليه و سلم يقول: أرسل إليّ أبو بكر عقب مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه:
إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة (1) بقراء القرآن، و إني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، و إني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول اللّه صلى الله عليه و سلم؟! قال عمر: هو و اللّه خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح اللّه صدري لذلك، و رأيت ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، و قد كنت تكتب الوحي لرسول اللّه صلى الله عليه و سلم فتتبع القرآن فاجمعه، فو اللّه لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول اللّه صلى الله عليه و سلم؟! قال: هو و اللّه خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح اللّه صدري للذي شرح له صدر أبي بكر و عمر ..
فتتبعت القرآن أجمعه من العسب و اللخاف، و صدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حتى خاتمة براءة .. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اللّه، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر.
و يذكر ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف: قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول اللّه صلى الله عليه و سلم شيئا من القرآن فليأت به، و كانوا يكتبون ذلك
ص: 85
1- موقعة بين المسلمين و المرتدين، كانت في السنة الثانية عشرة للهجرة و استشهد فيها سبعون من حفظة القرآن من الصحابة، و في هذا أيضا دليل على عناية الصحابة بحفظ القرآن.
في المصحف و الألواح و العسب، و كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. قال ابن حجر: و كان المراد بالشاهدين الحفظ و الكتاب.
و قال السخاوي في جمال القراء: المراد بأنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن.
و يبدو من المرويات أن عمر بن الخطاب كان يعين زيدا، و ربما أضاف إليهما عددا من الحفاظ الثقات كأبي بن كعب و علي بن أبي طالب، و عثمان ابن عفان، و كان زيد لا يقبل بالحفظ دون الكتابة، و جمع كله بالرواية المتواترة فزيد كان يحفظه و من معه كانوا يحفظون، ثم إن أبا خزيمة قد لقبه النبي صلى الله عليه و سلم بذي الشهادتين، و معنى هذا أن آخر براءة مثله مثل سائر القرآن قد اجتمع على حفظه و تواترت روايته، ثم أطلق على هذا المجموع اسم المصحف، و هي كلمة حبشية الأصل اقترحها ابن مسعود و وافق عليها الصحابة تمييزا له عن الإنجيل و التوراة، و على ذلك نقول: إن أبا بكر هو أول من جمع القرآن في مصحف واحد مرتب الآيات و السور، و يشتمل على الأحرف السبعة و إن بقيت إلى جواره مصاحف فردية لم تنقل القدر الكافي من التثبت و التحري في الجمع و الترتيب و الاقتصار على المتواتر المجمع على روايته.
و آل المصحف إلى عمر بعد وفاة الصديق- رضي اللّه عنهما- الذي أوصى بأن يحفظ بعده في بيت ابنته أم المؤمنين حفصة، و كانت- رضي اللّه عنها- تحفظ القرآن كله، كما كانت تعرف القراءة و الكتابة، و ظل محفوظا لديها إلى أن احتاجه عثمان بن عفان عند جمعه للقرآن في المصحف الإمام.
ثالثا: جمع القرآن في عهد عثمان:
اشارة
و هو الجمع الثالث للقرآن الكريم و قد كان الهدف مختلفا عن هدف أبي بكر أو بعبارة أدق قد كان لحاجة مختلفة أو لدواع مختلفة عن تلك التي اقتضت جمعه في المرة الثانية، فإذا كان أبو بكر قد انطلق من خوف أحس هو
ص: 86
و عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنهما- من ضياع شي ء من القرآن بموت حملته، فكان نقله لما كان مفرقا في الرقاع و الصحف و جمعه في مصحف واحد، فإن عثمان بن عفان قد انطلق من الخوف من اختلاف المسلمين على اتساع رقعة بلاد المسلمين و تعدد تلقيهم من الصحابة و بقاء المصاحف الفردية، فكان جمعه للمسلمين على مصحف واحد أو على حرف واحد.
ينقل السيوطي في الإتقان عن بعض مصادره: و الفرق بين جمع أبي بكر و جمع عثمان، أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شي ء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه و سلم، و جمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرءوا بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره، و اقتصر من سائر اللغات على لغة قريش، محتجا بأنه نزل بلغتهم، و إن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج و المشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة، و قال الحارث المحاسبي: المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، و ليس كذلك، إنما جعل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد، على اختيار وقع بينه و بين من شهده من المهاجرين و الأنصار، لما خشي الفتنة، عند اختلاف أهل العراق و الشام في حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن، فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق.
و يبدو السياق التاريخي لقصة الجمع هذه فيما يرويه البخاري عن صحابي جليل هو حذيفة بن اليمان أنه قدم على عثمان، و كان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية و أذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا
ص: 87
في الكتاب اختلاف اليهود و النصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت و عبد اللّه بن الزبير و سعيد بن العاص، و عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، و قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم و زيد بن ثابت في شي ء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، و أرسل إلى الآفاق الإسلامية بمصاحف مما نسخوا، و أمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، و يرجع ابن حجر ابتداء عمل هذه المجموعة في السنة الخامسة و العشرين للهجرة، و إن كان ارتباط هذا الصنيع بغزو أرمينية جعل بعض الباحثين يتأخرون به إلى السنة الثلاثين، و هي التي كان فيها الغزو، و كان عملهم قائما على مصحف حفصة بعد الانتهاء من نسخ عدة نسخ من مصحف الإمام و هذه التسمية ترجع إلى خطبة عثمان في الناس: «أنتم عندي تختلفون و تلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا و أشد لحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما» و ظلت صحف حفصة لديها حتى توفيت فأحرقها الخليفة الأموي مروان بن الحكم المتوفى سنة 65 ه.
أما عن العدد الذي نسخه عثمان من المصحف الإمام فاختلف حوله و أرجح الآراء أنها كانت سبع نسخ بعث بها إلى الأمصار ما عدا نسخة احتفظ بها في المدينة، و أباح لمن يشاء من الصحابة أن ينسخ لنفسه من هذا المصحف الإمام نسخه ففعل عبد اللّه بن الزبير و كذلك أمهات المؤمنين عائشة و حفصة و أم سلمة.
و كما رحب بعمل عثمان هذا أكثر الصحابة فقال علي بن أبي طالب:
«لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فو اللّه ما فعل في المصاحف إلا على ملأ منا» و قال أيضا: «لو وليت ما ولي عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل».
ص: 88
و قد وقف بعض الصحابة من هذا العمل موقف الإنكار، و على رأسهم عبد اللّه بن مسعود الذي أبى أن يحرق مصحفه، فيروي بعض الصحابة:
«فزعت فيمن فزع إلى عبد اللّه في المصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين، و لكن جئنا حين راعنا هذا الخبر، فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم على سبعة أحرف، و إن الكتاب قبلكم كان ينزل من باب واحد على حرف واحد» يرفض فكرة التحديد بعد أن أعطاهم رخصة قراءته و منحهم التوسعة بقراءته على أكثر من حرف و لكن ابن مسعود رجع إلى رأي الجماعة، و اقتنع بصواب ما قام به عثمان و كأنه عز عليه في البدء اجتهاده في رواية الحرف الذي قرأ عليه عن النبي صلى الله عليه و سلم، و تمسكه بما سمعه من حديث الأحرف السبعة، لكنه عاد، فاقتنع بأن مصلحة المسلمين تتحقق بهذا الصنيع و كان المصحف العثماني مرتبا على مائة و أربع عشرة سورة و لكنه كان مجردا من النقط و الشكل و أيضا من أسماء السور و الفواصل و أرقام الآيات و من هنا كان مشتملا على ما يمكن أن يحتمله رسمه من الأحرف السبعة فإنها لم تنسخ في كل موضع من القرآن، و إنما نسخت في بعض المواضع دون بعض.
أما ضبط الكلمات بالشكل (النقط) أي ضبط أواخر الكلمات بحركات الإعراب و هو ما يسمى بإعراب المصحف، فقد تم على يد أبي الأسود الدؤلي توفي سنة 69 ه قاضي البصرة بتكليف من زياد بن أبيه والي معاوية على البصرة، و كانت حركات الإعراب نقطا فقد وضع أبو الأسود الدؤلي نقطة فوق الحرف للدلالة على الفتحة، و نقطة تحته للدلالة على الكسرة، و نقطة بين يديه للدلالة على الضمة، و نقطتين للدلالة على التنوين، أما وضع النقط على الحروف المتشابهة أو ما يسمى بإعجام المصحف، فقد تم على يد نصر بن عاصم سنة 99 ه، و يجي ء ابن يعمر و الحسن البصري.
بتكليف من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، و الحجاج بن يوسف
ص: 89
الثقفي، و قد عبروا عن هذا بكلمة إعجام الحرف أي وضع نقطة عليه ليزيل عجمته أي إبهامه لأن أعجم في اللغة معناها أزال العجمة، فالهمزة هنا للسلب و النفي كما في أقسط بمعنى أزال الظلم، و لكن حتى لا يتداخل نقط الشكل مع نقط الإعجام، جعلوا الثانية بمداد مخالف لمداد الأولى، حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي توفي سنة 170 ه. فاستبدل بنقط الإعراب حركات الإعراب المعروفة، الفتحة و الكسرة و الضمة و التنوين و بقيت نقط الإعجام تفصل بين حروف الباء و التاء و الثاء و غيرها من الحروف التي تتشابه في رسمها الإملائي.
و بقي أن نفصح عن رأينا في وجوب التمسك بالرسم الإملائي العثماني (نسبة إلى مصحف عثمان بن عفان) حتى لا نقع تحت وطأة التساهل و التفريط و تفاوت قواعد الإملاء و تطورها، هذا و إن كنا بعيدا عن المصاحف و في أبحاثنا العلمية، نكتب الآيات وفق قواعد الإملاء المتعارف عليها في عصرنا و في وطننا، تسهيلا على أنفسنا و على تلاميذنا، و تبقى للنص القرآني قداسته لا تقبل التجزئة ..
ينقل السيوطي عن البيهقي في شعب الإيمان: «من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، و لا يخالفهم فيه، و لا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما و أصدق قلبا و لسانا، و أعظم أمانة، فلا ينبغي أن نظن أنفسنا استدراكا عليهم». الإتقان ج 2 ص 167.
فائدة:
معرفة سور القرآن كلها توقيفي كمعرفة آياته، و أطول سور القرآن هي سورة (البقرة)، و أقصر سور القرآن هي سورة (الكوثر)، و بين سورة البقرة و سورة الكوثر، سور كثيرة تختلف طولا و قصرا و مرجع ذلك إلى اللّه- تعالى- وحده لحكم سامية.
ص: 90
تقسيم مخارج الحروف:
اشارة
تنقسم مخارج (1) الحروف إلى قسمين: المخارج العامة و المخارج الخاصة، و المخارج العامة هي التي تشتمل على مخرج فأكثر و هي خمسة مخارج:
1- الجوف. 2- الحلق. 3- اللسان. 4- الشفتان. 5- الخيشوم.
و المخارج الخاصة: هي المحددة التي لا تشتمل إلا على مخرج واحد، و قد اختلف فيها العلماء فمنهم من عدها (سبعة عشر) مخرجا منحصرة في خمسة مخارج عامة، و منهم من عدها (ستة عشر)، و منهم من عدها (أربعة عشر) و سوف نفصل ذلك مع ذكر خلاف العلماء في موضعه إن شاء اللّه.
المخرج الأول من المخارج العامة: «الجوف»:
معنى الجوف: هو الخلاء، و هو الخلاء الواقع داخل الفم و الحلق.
الحروف التي تخرج من الجوف حروف المد:
1- الألف نحو (قال).
2- الواو المدية نحو (يقول).
3- الياء المدية نحو (قيل).
و هذه الحروف تسمى «جوفية» ذلك لأنها تخرج من الجوف، و تسمى «مدية» ذلك لامتداد الصوت عند النطق بها، و تسمى «هوائية» لأنها تنتهي بانقطاع هواء الفم، و تسمى حروف علة، و تسمى حروف «لين».
ص: 91
1- المخارج: جمع مخرج على وزن مفعل، بفتح الميم و سكون الخاء و فتح الراء، و المخرج لغة: محل الخروج، و اصطلاحا: اسم لموضع خروج الحرف و تمييزه عن غيره، كمدخل اسم لموضع الدخول، و مرقد اسم لموضع الرقود. و مخارج الحروف هي بمثابة الموازين تعرف بها مقاديرها، فتتميز عن بعضها، و طريقة معرفة مخرج الحرف هي النطق به ساكنا، أو مشددا، ثم تدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة كانت، فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه المحقق.
المخرج الثاني من المخارج العامة: «الحلق»:
و في الحلق ثلاثة مخارج تخرج منها ستة أحرف و هي:
1- أقصى الحلق: أي مما يلي الصدر و يخرج منه الهمزة و الفاء.
2- وسط الحلق: و هو ما بين أقصاه و أدناه و يخرج منه العين و الحاء.
3- أدنى الحلق: أي أقربه مما يلي الفم و يخرج منه الغين و الخاء، و إلى ذلك أشار صاحب التحفة في حروف الحلق فقال:
همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء
المخرج الثالث من المخارج العامة: «اللسان»:
و فيه عشرة مخارج تخرج منها ثمانية عشر حرفا و هي:
1- أقصى اللسان من فوق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى و يخرج منه (ق).
2- أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، و يخرج منه (ك) إلا أن مخرجها أسفل من مخرج ال (ق).
3- وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، و يخرج منه (الجيم فالشين فالياء غير المدية).
4- إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا اليسرى أو اليمنى، و يخرج منه (ض)، و تسمى الضاد مستطيلة لاستطالة مخرجها، و النطق بالضاد كاملا من مميزات العربي؛ لأن الضاد لا توجد إلا في اللغة العربية، و لذا تسمى لغة الضاد، و قد تميز النبي صلى الله عليه و سلم بكامل نطقه بها فقال: «أنا أفصح من نطق بالضاد» و يقول الشاعر في مدحه صلى الله عليه و سلم في ذلك:
ثم صلاة اللّه ما ترنما حاد بسوق العس في أرض
على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد
5- أدنى حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يحاذيها من اللثة العليا، و يخرج منه (ل).
ص: 92
6- طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا مع ما يليه من لثة الأسنان العليا، و يخرج منه (ن).
7- طرف اللسان قريب إلى ظهره قليلا بعد مخرج النون، و يخرج منه (الراء).
8- طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا و السفلى قريب إلى طرف الثنايا السفلى و يخرج منه (ص- ز- س).
9- ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا و يخرج منه (ط- د- ت).
10- ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، و يخرج منه (ظ- ذ- ث).
المخرج الرابع من المخارج العامة: «الشفتان»:
و فيهما مخرجان:
1- بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا و يخرج منه حرف (ف).
2- ما بين الشفتين معا، و يخرج منه ثلاثة أحرف و هي (ب- م- و).
المخرج الخامس من المخارج العامة: «الخيشوم»:
الخيشوم هو أقصى الأنف من الداخل و فيه مخرج واحد تخرج منه (الغنة).
ترتيب المخارج الخاصة الفرعية حسب ورودها في المخارج العامة:
1- مخرج الجوف و منه حروف المد الثلاثة (الألف- الواو- الياء).
2- أقصى الحلق و يخرج منه (الهمزة- و الهاء).
3- وسط الحلق و يخرج منه (العين- و الحاء).
4- مخرج أدنى الحلق، و يخرج منه (الغين- و الخاء).
5- أقصى اللسان، و يخرج منه (القاف- الكاف).
ص: 93
6- وسط اللسان، و يخرج منه (الشين- الجيم- الياء).
7- حافتي اللسان و تخرج منه (ض- ل).
8- طرف اللسان و يخرج منه الحروف (النون- الراء- الصاد- الزاي- السين- الطاء- الدال- التاء- الظاء- الذال- الثاء).
9- بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، و يخرج منه حرف (الفاء).
10- الشفتان معا و تخرج منهما (الواو- الباء- الميم).
11- مخرج الخيشوم، يخرج منه (الغنة).
ترتيب المخارج بترتيب حروف المعجم:
اشارة
1- أ (الهمزة) تخرج من أقصى الحلق.
2- ا (الألف) المدية، تخرج من الجوف.
3- ب (الباء) تخرج من الشفتين معا.
4- ت (التاء) تخرج من طرف اللسان.
5- ث (الثاء) تخرج من طرف اللسان.
6- ج (الجيم) تخرج من وسط اللسان.
7- ح (الحاء) تخرج من وسط الحلق.
8- خ (الخاء) تخرج من أدنى الحلق.
9- (الدال) تخرج من طرف اللسان.
10- ذ (الذال) تخرج من طرف اللسان.
11- ر (الراء) تخرج من طرف اللسان.
12- ز (الزاي) تخرج من طرف اللسان.
13- س (السين) تخرج من طرف اللسان.
14- ش (الشين) تخرج من وسط اللسان.
15- ص (الصاد) تخرج من طرف اللسان.
ص: 94
16- ض (الضاد) تخرج من حافة اللسان.
17- ط (الطاء) تخرج من طرف اللسان.
18- ظ (الظاء) تخرج من طرف اللسان.
19- ع (العين) تخرج من وسط الحلق.
20- غ (الغين) تخرج من أدنى الحلق.
21- ف (الفاء) تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا.
22- ق (القاف) تخرج من أقصى اللسان.
23- ك (الكاف) تخرج من أقصى اللسان.
24- ل (اللام) تخرج من حافة اللسان.
25- م (الميم) تخرج من الشفتين معا.
26- ن (النون) تخرج من طرف اللسان.
27- ه (الهاء) تخرج من أقصى الحلق.
28- و (الواو) تخرج من الجوف.
29- ي (الياء) تخرج من الجوف.
فائدة:
اعلم أن حروف الهجاء (1) عند أحكام (النون الساكنة و التنوين) يكون عددها ثمانية و عشرين حرفا فقط، فللإظهار ستة، و للإدغام ستة، و للإقلاب واحد، و للإخفاء خمسة عشر حرفا، أما حروف المد الثلاث و هي (الألف- و الواو- و الياء) فلا تقع بعد النون الساكنة و التنوين مطلقا لكي لا يلتقي الساكنان.
و كذا الحكم عند (الميم الساكنة و اللامات السواكن يكون عدد الحروف الهجائية ثمانية و عشرين حرفا أيضا لهذا السبب، أما عند (مخارج
ص: 95
1- انظر غاية المريد ص 131، 130.
الحروف) فيكون عددها واحدا و ثلاثين حرفا، فالجوف يخرج منه ثلاثة أحرف، و الحلق ستة أحرف، و اللسان ثمانية عشر، و الشفتان أربعة.
و كذا عند (صفات الحروف) يكون عددها واحدا و ثلاثين حرفا أيضا.
و إليك جدول و رسم توضيحي يقرب تحديد تلك المخارج موضحة بالشكل:
ص: 96
جدول بمخارج الحروف العامة و الخاصة
ص: 97
ألقاب الحروف عشرة:
اشارة
لقد اشتهرت ألقاب الحروف عند علماء هذا الفن بأنها عشرة ألقاب اصطلح عليها العلماء، و إليك هذه الألقاب مرتبة بحسب المواضع التي تخرج منها و هي:
حروف حلقية، و حروف لهوية، و حروف شجرية، و حروف أسلية، و حروف نطعية، و حروف لثوية، و حروف ذلقية، و حروف شفهية، و حروف جوفية، و حروف هوائية و إليك بيانها بشي ء من التفصيل:
1- الحروف الحلقية:
و هي ستة، تخرج من الحلق، و لذا سميت حلقية، و هي: (الهمزة، و الهاء، و العين، و الحاء، و الغين، و الخاء) و تجمع من أوائل كلم العبارة: «إن غاب عني حبيبي همني خبره».
2- الحروف اللهوية:
و هما حرفان، لقبا بذلك لخروجهما من قرب اللهاة، و هي اللحمة المدلاة في أقصى سقف الحلق، و هما: القاف، و الكاف.
3- الحروف الشجرية: و لقبت بذلك لخروجها من شجر الفم أي ملتقى ما بين اللحيين، و هي ثلاثة (الجيم، و الشين، و الياء) و قد زاد صاحب لآلئ البيان حرفا رابعا و هو الضاد، حيث قال- رحمه اللّه-:
و الجيم و الشين و ياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت
4- الحروف الأسلية:
و لقبت بذلك لخروجها من أسلة اللسان أي طرفه، و هي ثلاثة: (الصاد- و الزاي- و السين).
5- الحروف النطعية:
و لقبت بذلك لخروجها من قرب نطع الفم أي غاره، و هو الجزء الأمامي من الحنك الأعلى، و هي ثلاثة: (الطاء، و الدال، و التاء).
6- الحروف اللثوية:
و لقبت بذلك لقرب مخرجها من اللثة، و هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان، و يسمى بأصول الأسنان، و هي ثلاثة: (الظاء، و الذال، و الثاء).
ص: 98
7- الحروف الذلقية:
و لقبت بذلك لخروجها من ذلق اللسان و هي ثلاثة: (اللام- و الراء- و النون)
8- الحروف الشفهية:
و لقبت بذلك لخروج الفاء من بطن الشفة السفلى، و خروج الباقي من الشفتين معا، و هي: (الفاء- و الواو- و الباء- و الميم).
9- الحروف الجوفية:
و لقبت بذلك لخروجها من الجوف، و هي حروف المد الثلاثة.
10- الحروف الهوائية:
لقبت بذلك، لأن خروجها ينتهي بانقطاع هواء الفم و هذه الحروف هي حروف الجوف.
و لقد أشار صاحب لآلئ البيان إلى هذه الألقاب العشرة فقال:
و أحرف المد إلى الجوف انتمت ***و هكذا إلى الهواء نسبت
و أحرف الحلق أتت حلقية ***و القاف و الكاف معا الهوية
و الجيم و الشين و ياء لقبت ***مع ضادها شجرية كما ثبت
و اللام و النون و را ذلقية ***و الطاء و الدال و تا نطعية
و أحرف الصفير قل أسلية ***و الظاء و الذال و ثا لثوية
و الفاء و ميم با و واو سميت ***شفوية فتلك عشرة أتت
ص: 99
خلاف العلماء حول عدد مخارج الحروف
اشارة
لقد اختلف علماء التجويد و اللغة في عدد مخارج الحروف العامة و الخاصة، و قد ورد الخلاف في كتاب العميد، و إليك تفصيله:
رأي جمهور العلماء في عدد المخارج:
ذهب جمهور العلماء، و منهم ابن الجزري- رحمه اللّه-، و الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أن عدد المخارج الخاصة سبعة عشر مخرجا في خمسة مخارج عامة و هي:
1- الجوف: و يشتمل على مخرج واحد.
2- الحلق: و يشتمل على ثلاثة مخارج.
3- اللسان: و يشتمل على عشرة مخارج.
4- الشفتان: و يشتمل على مخرجين.
5- الخيشوم: و يشتمل على مخرج واحد.
- رأي الشاطبي و سيبويه و موافقيهما في عدد مخارج الحروف:
ذهب بعض علماء التجويد و اللغة و منهم الشاطبي و سيبويه إلى أن المخارج الخاصة ستة عشر مخرجا تنحصر في أربعة مخارج عامة هي:
1- الحلق بمخارجه الثلاثة.
2- اللسان بمخارجه العشرة.
3- الشفتان بمخرجيهما.
4- الخيشوم بمخرجه.
و أسقطوا الجوف (1)، و وزعوا الحروف التي تخرج منه و هي حروف المد على مخارج أخرى، فجعلوا الألف المدية مع الهمزة من أقصى الحلق، و الياء المدية مع غير المدية من وسط اللسان، و الواو المدية مع غير المدية من الشفتين.
ص: 100
1- العميد ص 47.
رأي الفراء و موافقيه في عدد مخارج الحروف:
و ذهب بعض علماء التجويد و اللغة، و منهم الفراء و يحيى و قطرب و الجرمي إلى أن المخارج الخاصة أربعة عشر مخرجا تنحصر في أربعة مخارج عامة و هي:
1- الحلق بمخارجه الثلاثة.
2- اللسان بمخارجه الثمانية.
3- الشفتان بمخرجيهما.
4- الخيشوم بمخرجه.
و أسقطوا الجوف، و وزعوا الحروف التي تخرج منه كالمذهب السابق، و زادوا أن اللام و النون و الراء تخرج من مخرج واحد و هو طرف اللسان و بذلك جعلوا مخارج اللسان ثمانية بدلا من عشرة.
فائدة:
ذكر فضيلة الشيخ محمود علي بسه في العميد (1) أن الاختلاف في عدد مخارج الحروف مبني على التقريب لا على التحديد، إذ أن المخارج لا بدّ أن تتعدد بتعدد الحروف الهجائية التي لا بدّ لكل منها مخرج خاص به يميزه عن غيره من الحروف، فالأقوال المبنية على خروج أكثر من حرف من مخرج واحد هي على سبيل التقريب لا التحديد.
يقول الإمام ابن الجزري مشيرا إلى أن مخارج الحروف السبعة عشر:
مخارج الحروف سبعة عشر ***على الذي يختاره من اختبر
فألف الجوف و أختاها و هي ***حروف مد للهواء تنتهي
ثم لأقصى الحلق همز هاء ***ثم لوسطه فعين حاء
ص: 101
1- العميد ص 48.
أدناه غين خاؤها أقصى ***اللسان فوق ثم الكاف
أسفل و الوسط فجيم الشين ***و الضاد من حافته إذ وليا
الأضراس من أيسر أو ***و اللام أدناها لمنتهاها
و النون من طرفة تحت ***و الرا يدانيه لظهر أدخل
و الطاء و الدال و تامنه ***عليا الثنايا و الصفير مستكن
منه و من فوق الثنايا ***و الظاء و الذال و ثا للعليا
من طرفيها و من بطن الشفة ***فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة
للشفتين الواو باء ميم ***و غنة مخرجها الخيشوم
ص: 102
تقسيم صفات الحروف
إجمالي صفات الحروف:
إجمالي (1) صفات الحروف:
لقد اختلف العلماء في عدد الصفات فذهب ابن الجزري- رحمه اللّه- إلى أنها ثماني عشرة صفة، و عدها بعضهم عشرين، و زاد بعضهم حتى أوصلها إلى أربع و أربعين.
و تنقسم الصفات إلى قسمين: ذاتية و عرضية.
و الذاتية: هي الصفة التي تلازم الحرف و لا تفارقه كالقلقلة.
و العرضية: هي الصفة التي تلحق بالحرف حينا و تفارقه حينا آخر.
و تنقسم الصفات الذاتية إلى قسمين:
الأول: صفات لها ضد.
الثاني: صفات ليس لها ضد.
و الصفات التي لها ضد هي: الجهر و ضده الهمس، و الرخاوة و ضدها الشدة، و بينها صفة التوسط، التي يقال لها: البينية- أي: بين الرخاوة و الشدة-، و الاستفال و ضده الاستعلاء، و الانفتاح و ضده الإطباق، و الإصمات و ضده الإذلاق.
و الصفات التي ليس لها ضد هي: الصفير، و القلقلة، و اللين، و الانحراف، و التكرير، و التفشي، و الاستطالة، و الخفاء، و الغنة.
ص: 103
1- الصفة في اللغة ما قام بالشي ء من المعاني كالسواد و البياض، و في الاصطلاح: كيفية ثابتة للحرف عن نطقه، و تعتبر الصفات بمثابة المعايير للحروف، و فوائد الصفات ثلاث: 1- تمييز الحروف المشتركة في المخرج. 2- معرفة القوي من الضعيف ليعلم ما يجوز إدغامه و ما لا يجوز فإن ما له قوة و مزية عن غيره لا يجوز أن يدغم في ذلك الغير لئلا تذهب تلك المزية. 3- تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج.
و من هنا نعلم أن الصفات التي لها ضد تصل إلى إحدى عشرة صفة، و الصفات التي ليس لها ضد تصل إلى تسع صفات.
تفصيل الصفات كلها:
1- الهمس:
الهمس لغة: الخفاء، و اصطلاحا: خفاء الحرف لضعفه عند النطق به، و حروف الهمس هي: (فحثه شخص سكت) و هذه الحروف عشرة، و العبارة من أقوال ابن الجزري- رحمه اللّه- و هذه الحروف هي: (الفاء- و الحاء- و الثاء- و الهاء- و الشين- و الخاء- و الصاد- و السين- و الكاف- و التاء).
2- الجهر:
(و هو ضد الهمس).
الجهر لغة: الظهور و الإعلان، و اصطلاحا: انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه.
و حروف الجهر (واحد و عشرون) حرفا و هي حروف الهجاء الباقية بعد حروف الهمس، و هي: (الهمزة- و الباء- و الجيم- و الدال- و الذال- و الراء- و الزاي- و الضاد- و الطاء- و الظاء- و العين- و الغين- و القاف- و اللام- و الميم- و النون- و الواو- و الياء- و الألف- و الواو المدية- و الياء المدية).
3- الشدة:
الشدة لغة: القوة، و اصطلاحا: انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه.
و حروف الشدة (ثمانية) أشار إليها ابن الجزري في قوله: (أجد قط بكت) و هي: (الهمزة- و الجيم- و الدال- و القاف- و الطاء- و الباء- و الكاف- و التاء).
4- التوسط:
و التوسط لغة: الاعتدال، و اصطلاحا: اعتدال الصوت عند النطق بالحرف.
ص: 104
و حروف التوسط (خمسة) تجمع في قول ابن الجزري: (لن عمر)، و هي: (اللام- و النون- و العين- و الميم- و الراء).
5- الرخاوة:
و الرخاوة لغة: اللين، و اصطلاحا: جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه، و حروف الرخاوة (ثمانية عشر) و هي الحروف الباقية من حروف الهجاء بعد صفة الشدة و التوسط و هي: (الثاء- و الحاء- و الخاء- و الذال- و الزاي- و السين- و الشين- و الصاد- و الضاد- و الظاء- و الغين- و الفاء- و الهاء- و الواو- و الياء- و الألف- و الواو المدية- و الياء المدية).
6- الاستعلاء:
و الاستعلاء لغة: العلو و الارتفاع، و اصطلاحا: ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى.
و حروفه جمعها الإمام المحقق ابن الجزري في قوله: (خص ضغط قظ) و هي: (الخاء- و الصاد- و الضاد- و الغين- و الطاء- و القاف- و الظاء)، و هذه الحروف تفخم قولا واحدا.
7- الاستفال:
(و هو ضد الاستعلاء).
و الاستفال لغة: الانخفاض، و اصطلاحا: انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأغلب حروفه و حروف الاستفال (أربعة و عشرون) حرفا الباقية من أحرف الهجاء بعد حروف الاستعلاء و هي: (الهمزة- و الباء- و التاء- و الثاء- و الجيم- و الحاء- و الدال- و الذال- و الراء- و الزاي- و السين- و الشين- و العين- و الفاء- و الكاف- و اللام- و الميم- و النون- و الهاء- و الواو- و الياء- و الألف- و الواو المدية- و الياء المدية).
8- الإطباق:
و الإطباق لغة: الإلصاق، و اصطلاحا: إطباق اللسان على الحنك الأعلى
ص: 105
عند النطق بحروفه بحيث ينحصر الصوت بينهما.
و حروف الإطباق (أربعة) و هي: (الصاد- و الضاد- و الطاء- و الظاء) إلا أن هناك تفاوتا بينها من حيث القوة.
9- الانفتاح:
و الانفتاح لغة: الافتراق، و اصطلاحا: تجافي اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج الريح عند النطق بأغلب حروفه.
و حروفه (سبعة و عشرون) حرفا، و هي الحروف الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإطباق و هي: (الهمزة- الباء- التاء- الثاء- الجيم- الحاء- الخاء- الدال- الذال- الراء- الزاي- السين- الشين- العين- الغين- الفاء- القاف- الكاف- اللام- الميم- النون- الهاء- الواو- الياء- الألف- الواو المدية- الياء المدية).
10- الإذلاق:
و الإذلاق لغة: حدة اللسان و بلاغته، و اصطلاحا: خفة الحرف و سرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان، أي: طرفه، أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا.
و حروف الإذلاق (ستة) جمعت في قول ابن الجزري: (فر من لب) و هي: (الفاء- و الراء- و الميم- و النون- و اللام- و الباء).
11- الإصمات:
(ضد الإذلاق).
و الإصمات لغة: المنع، و اصطلاحا: ثقل الحرف و عدم سرعة النطق به.
و حروف الإصمات (خمسة و عشرون) حرفا، و هي الحروف الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإذلاق و هي:
(الهمزة- التاء- الثاء- الجيم- الحاء- الخاء- الدال- الذال- الزاي- السين- الشين- الصاد- الضاد- الطاء- الظاء- العين- الغين- القاف- الكاف- الهاء- الواو- الياء- الألف- الواو المدية- الياء المدية).
ص: 106
و بذلك تمت الصفات التي لها ضد، و إليك الصفات التي ليس لها ضد و هي:
12- الصفير:
و الصفير لغة: صوت يشبه صوت الطائر، و اصطلاحا: صوت زائد يخرج من بين الثنايا و طرف اللسان عند النطق بأحد حروفه.
و حروف الصفير ثلاثة هي: (الصاد- الزاي- السين).
13- القلقلة:
و القلقلة لغة: الاضطراب، و اصطلاحا: اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية.
و حروف القلقلة خمسة، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله: (قطب جد)، و أعلى الحروف قلقلة هو الطاء، و أوسط الحروف هو الجيم، و أدنى الحروف باقيها.
و قد أشار صاحب التحفة السمنودية بقوله:
قلقلة (قطب جد) و قربت لفتح مخرج على الأولى ثبت
كبيرة حيث لدى الوقف أتت أكبر حيث عند وقف شددت
14- اللين:
و اللين لغة: السهولة، و اصطلاحا: إخراج الحرف من مخرجه بسهولة و عدم كلفة على اللسان.
و حرفاه، اثنان و هما: الواو و الياء، و الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو:
خوف، بيت.
15- الانحراف:
و الانحراف لغة: الميل و العدول، و اصطلاحا: الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر.
ص: 107
و حرفاه اثنان، و هما: اللام و الراء، و وصفا بالانحراف لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما.
16- التكرير:
و التكرير لغة: الإعادة، و اصطلاحا: ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف. و حرف التكرير واحد هو الراء.
17- التفشي:
و التفشي: لغة: الانتشار، و اصطلاحا: انتشار خروج الريح بين اللسان و الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. و حرف التفشي واحد هو الشين.
18- الاستطالة:
و الاستطالة لغة: الامتداد، و اصطلاحا: امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها. و حرف الاستطالة واحد هو الضاد.
19- الخفاء:
و الخفاء لغة: الاستتار، و اصطلاحا: خفاء صوت الحرف عند النطق به.
و حروف صفة الخفاء (أربعة) حروف المد الثلاثة، و الهاء، تجمع في قولك: (هواي).
20- الغنة:
و الغنة لغة: صوت له رنين في الخيشوم، و اصطلاحا: صوت لذيذ مركب من جسم النون و الميم في كل الأحوال.
و حروف الغنة اثنان، و هما: الميم و النون المشددتين.
فائدة:
من الصفات السابقة منها هو قوي و منها ما هو ضعيف، و كذلك يترتب عليه أن الحروف الهجائية منها ما هو قوي، و منها ما هو ضعيف، و ذلك يعود إلى الصفات التي يتصف بها كل حرف.
ص: 108
جدول للمقارنة بين صفات الحروف و هو كملخص لصفات حروف الهجاء
الصورة
ص: 109
الصورة
ملاحظات على الجدول السابق:
1- من المعلوم أن التوسط هو البينية بين الشدة الرخاوة، و لذا عند التعريف يقال للتوسط: الاعتدال، و الفرق بين الصفات الثلاث أي الشدة و التوسط و الرخو قائم على جريان الصوت و عدمه، فما جرى معه الصوت رخوي، و ما انحبس معه الصوت شديد، و ما لم يكمل الانحباس و الجريان معه متوسط، و حروف الهجاء مقسمة بين هذه الصفات الثلاث فما كان من حروف (أجد قط بكت) سمي شديدا، و ما كان من حروف (لن عمر) سمي متوسطا، أو بينيا، و ما لم يكن من هذه و لا تلك سمي رخويا، و اللّه أعلى و اعلم.
2- صفة التكرير من الصفات التي لا ضد لها، و يجب الحذر من هذه الصفة لا فعلها، فإن اهتزاز طرف اللسان عند النطق به يؤدي إلى خروج أكثر من راء في وقت واحد، و هو الممنوع في علم التجويد، فالواجب إخراج راء واحدة، فهو عكس كل الصفات، و هو من الصفات التي يجب تجنبها
ص: 111
بعكس كل الصفات التي يجب فعلها.
3- الصفات التي لها ضد هي: الجهر و ضده الهمس، و الرخو و ضده التوسط، و الشدة و الاستفال و ضده الاعتدال، و الانفتاح و ضده الإطباق، و الإصمات و ضده الإذلاق.
و الصفات التي لا ضد لها هي: الصفير، و القلقلة، و اللين، و الانحراف، و التكرير، و التفشي، و الاستطالة، و بذلك يتم عدد الصفات فهو يصل إلى ثماني عشرة صفة.
ص: 112
جدول عدد صفات كل حرف مرتبة على حروف المعجم
الصورة
ص: 113
تماثل و تقارب و تجانس و تباعد الحروف
أولا: التماثل:
المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا اسما و مخرجا و صفة كالدالين في قوله تعالى: وَ قَدْ دَخَلُوا في المائدة.
و ينقسم المتماثلان إلى ثلاثة أقسام هي:
1- المتماثلان الصغير: الحرف الأول منهما ساكن، و الثاني متحرك مثل: اذْهَبْ بِكِتابِي هذا بالنمل، فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ، اضْرِبْ بِعَصاكَ، أَقُلْ لَكُمْ، وَ هُمْ مِنْ، عَنْ نَفْسٍ، يُدْرِكْكُمُ.
2- المتماثلان الكبير: الحرفان متحركان مثل: مَناسِكَكُمْ بالبقرة، (الرحيم ملك)، فَأَنْتَ تُسْمِعُ، شَهْرُ رَمَضانَ، النَّاسَ سُكارى، يَشْفَعُ عِنْدَهُ.
3- المتماثلان المطلق: الحرف الأول متحرك، و الثاني ساكن عكس المتماثلين الصغير تماما، و مثل: ما نَنْسَخْ، شَقَقْنَا، فَأَحْيَيْنا، تَتْرا.
ثانيا: التقارب:
اشارة
المراد بالتقارب في الحروف هو التقارب النسبي لشموله لكل ما ورد فيه الرواية بالإدغام سواء كان الحرفان من عضو واحد أو من عضوين مختلفين، و ينقسم المتقاربان إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول:
هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا و صفة، و يشتمل على ثلاثة أقسام:
1- الصغير: كالتاء مع التاء نحو: كَذَّبَتْ ثَمُودُ.
2- الكبير: كالقاف مع الكاف نحو: مِنْ فَوْقِكُمْ.
3- المطلق: كالتاء مع الثاء نحو: وَ لا يَسْتَثْنُونَ.
النوع الثاني:
هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة، و يشتمل أيضا على ثلاثة أقسام هي:
ص: 115
1- الصغير، كالدال مع السين نحو: لَقَدْ سَمِعَ.
2- الكبير، كالدال مع السين نحو: عَدَدَ سِنِينَ.
3- المطلق، كالسين مع النون نحو: سُنْدُسٍ.
النوع الثالث:
هما الحرفان اللذان تقاربا صفة لا مخرجا و يشتمل كذلك على ثلاثة أقسام:
1- الصغير: كالذال مع الجيم نحو: إِذْ جاءَكُمْ.
2- الكبير: كالقاف مع الدال نحو: بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ.
3- المطلق: كالقاف مع الطاء نحو: يَلْتَقِطْهُ.
ثالثا: التجانس:
المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا و اختلفا صفة، و يشتمل على ثلاثة أقسام:
1- الصغير: كالتاء مع الدال نحو: أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما.
2- الكبير: كالتاء مع الطاء نحو: الصَّالِحاتِ طُوبى.
3- المطلق: كالتاء مع الطاء نحو: أَ فَتَطْمَعُونَ.
رابعا: التباعد:
الحرفان المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا و اختلفا صفة كالتاء مع الخاء في تُخْرِجُونَ، أو تباعدا مخرجا و اتفقا صفة كالكاف مع التاء من فَاكْتُبُوهُ، و يشتمل على ثلاثة أقسام:
1- الصغير: كالنون مع الخاء في: وَ الْمُنْخَنِقَةُ.
2- الكبير: كالدال مع الهاء في: دِهاقاً.
3- المطلق: كالهاء مع الميم في: أَنْفُسَهُمْ.
ص: 116
حكم المثلين و المتقاربين و المتجانسين و المتباعدين
1- حكم المثلين:
الصغير: حكمه: وجوب الإدغام.
الكبير: حكمه: وجوب الإدغام عند حفص إلا في كلمتين هما: تَأْمَنَّا بيوسف، و مَكَّنِّي من قوله تعالى: قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ بسورة الكهف.
المطلق: حكمه وجوب الإظهار عند جميع القراء.
2- حكم المتقاربين:
المتقاربان الصغير في الأنواع الثلاثة حكمه وجوب الإظهار عند حفص إلا في اثنتين و ثلاثين مسألة متفق على عدم إظهارها، و مسألة واحدة مختلف في إدغامها إدغاما كاملا أو ناقصا (1).
حكم المتجانسين:
المتجانسان الصغير حكمه وجوب الإظهار مطلقا إلا في ثمان مسائل، منها ست متفق على إدغامها إدغاما كاملا و هي:
1- الباء التي بعدها ميم في: ارْكَبْ مَعَنا.
2- التاء التي بعدها دال في: أَثْقَلَتْ دَعَوَا.
3- التاء التي بعدها طاء في: إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ.
4- الثاء التي بعدها ذال في: يَلْهَثْ ذلِكَ.
5- الدال التي بعدها تاء مثل: وَ مَهَّدْتُ.
6- الذال التي بعدها ظاء نحو: إِذْ ظَلَمْتُمْ.
و مسألة واحدة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا و هي: الطاء التي بعدها تاء مثل: أَحَطْتُ.
ص: 117
1- غاية المريد ص (175).
و مسألة واحدة مختلف فيها بين الإظهار و الإخفاء و هي: الميم الساكنة التي بها باء مثل: تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ و قد سبقت الإشارة في باب الميم الساكنة إلى أن الإخفاء هو قول الجمهور من أهل الأداء، و قيل بإظهارها.
و أما حكم المتجانسين الكبير و المطلق فالإظهار دائما (1).
حكم المتباعدين:
المتباعدان الصغير حكمه الإظهار مطلقا إلا في مسألتين متفق على الإخفاء فيهما و هما:
1- النون الساكنة التي بعدها قاف نحو قوله تعالى: فَانْقَلَبُوا.
2- النون الساكنة التي بعدها كاف نحو قوله تعالى: أَنْكالًا.
و أما حكم المتباعدين الكبير و المطلق: فالإظهار دائما.
فائدة:
إلى هذه الأنواع الأربعة و أقسامها يشير الشيخ إبراهيم شحاتة في التحفة السمنودية في تجويد الكلمات القرآنية بقوله- رحمه اللّه-:
إن يجتمع حرفان خطا ***حي على الظاهر فيما قسما
فمتماثلان إن يتحدا ***في مخرج و صفة كما بدا
و متجانسان إن تطابقا ***في مخرج لا في الصفات اتفقا
و متقاربان حيث فيهما ***تقارب أو كان في أيهما
و متباعدان حيث مخرجا ***تباعدا و الخلف في الصفات جا
و حيثما تحرك الحرفان في ***كل فسم بالكبير و اقتف
وسم بالصغير حيثما ***أولهما و مطلق في العكس عن
كما أشار صاحب التحفة إلى الأنواع الثلاثة بقوله:
إن في الصفات و المخارج ***حرفان فالمثلان فيهما أحق
ص: 118
1- انظر المرجع السابق ص 177، 178.
أو أن يكونا مخرجا تقاربا ***و في الصفات اختلفا يلقبا
متقاربين أو يكون اتفقا ***في مخرج دون الصفات حققا
بالمتجانسين ثم إن سكن ***أول كل فالصغير سمين
أو حرك الحرفان في كل ***كل كبير و افهمنه بالمثل (1)
الوقف و الابتداء:
اشارة
الوقف (2) و الابتداء:
سبق أن أشرنا إشارة خفيفة إلى أهمية الوقف و الابتداء للقارئ و ذلك في موضوع ما يجب على القارئ أن يتعلمه قبل معرفة أحكام التجويد، و قلنا أن الوقف و الابتداء من أهم موضوعات التجويد التي لا بد للقارئ من معرفتها، و من مراعاتها في قراءته ما أمكن.
أهمية الوقف و الابتداء و فوائدهما و الأصل في ذلك :
اشارة
أهمية الوقف و الابتداء و فوائدهما و الأصل في ذلك (3):
الوقف و الابتداء من أهم موضوعات التجويد التي لا بد للقارئ من معرفتها، و من مراعاتها في قراءاته ما أمكن، و من إحاطته بالعلوم التي تبصره بهما و تجعله قادرا على تمييز ما جاز منهما مما لم يجز كعلوم: التفسير- و أسباب الترول- و الرسم العثماني- و عدّ الآي- و النحو و البلاغة.
و ذلك لما للوقف و الابتداء من فوائد كثيرة للسامع و القارئ تتلخص في أمرين:
ص: 119
1- وردت هذه الأبيات في تحفة الأطفال، و هي من تأليف سليمان الجمزوري- رحمه اللّه- و فيه أي في متنه شمل الأحكام دون الصفات و المخارج.
2- الوقف لغة: الحبس و الكف و اصطلاحا: قطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمن مع التنفس و قصد العودة إلى القراءة في الحال، و يكون في آخر السورة، و في آخر الآية، و في أثنائها، و لا يكون وسط الكلمة، و لا فيما اتصل رسما كالوقف على إِنَّ في قوله تعالى: فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، و هذا مختصر و سوف نفصله داخل الباب.
3- هذا الباب نقلا عن فتح المجيد ص 135 بتصرف
أحدهما:
إيضاح المعاني القرآنية للمستمع كلما كان القارئ أقدر على تحري ما حسن من الوقف و الابتداء في قراءته، و ما يوضح المعنى المراد، و كلما حرص على ذلك.
و الثاني:
دلالة وقف القارئ في تقدير درجات الوقف جودة و رداءة، تبعا لتفاوتهم في فهم القرآن، و مقدار إحاطتهم بهذه العلوم و قد أدرك المتقدمون ما للوقف و الابتداء من أهمية و فوائد، حتى أنهم كتبوا كتبا خاصة بهما ككتابي: «التمهيد في الوقف و الابتداء» و ما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم في كثير من الأحاديث من أنه كان يقف على رءوس الآي، و أنه كان يقطع قراءته فيقول:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و يقف، ثم يقول: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ و يقف ثم يقول: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و يقف، و هكذا و أنه كان يقرئ أصحابه على مثل ذلك، و يعلمه لهم، و أن عليّا رضي الله عنه سئل عن معنى قوله تعالى: وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فقال: الترتيل هو تجويد الحروف و معرفة الوقوف، و الوقف هو حلية التلاوة و زينة القارئ و بلاغ التالي، و فهم المستمع، و فخر العالم.
حكم الوقف شرعا:
ثم إنه لا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه، و لا وقف حرام يأثم القارئ بفعله، و إنما يرجع وجود الوقوف و تحريمها إلى ما يقصده القارئ منها، و ما يترتب على الوقف و الابتداء من إيضاح المعنى المراد، أو إيهام غيره مما ليس مرادا و كل ما ثبت شرعا في هذا الصدد هو سنية الوقف على رءوس الآي، و كراهة تركه عليها، و جوازه على ما عداها ما لم يوهم خلاف المعنى المراد.
ص: 120
تعريف الوقف و الوصل و السكت و القطع و محل كل منها:
الوقف لغة: الحبس و الكف، و اصطلاحا: قطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمن مع التنفس و قصد العودة إلى القراءة في الحال، و يكون في آخر السورة، و في آخر الآية، و في أثنائها.
و لا يكون وسط الكلمة، و لا فيما اتصل رسما كالوقف على إن في فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ بهود. و قد يوجد وقفان متعاقبان في لفظين متواليين إذا وقف على أحدهما لم يجز الوقف على الآخر، و هو ما يعرف بين القراءة بتعانق الوقف و تعاقبها، و ذلك نحو: لا رَيْبَ فِيهِ بالبقرة، جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ بفصلت. فإنه يجوز الوقف في الأولى على كل من رَيْبَ و فِيهِ و في الثانية على كل من: لفظ الجلالة، و لفظ النار.
فإن وقف على أحدهما لم يجز الوقف في الأصل إلا بالسكون المحض، و قد يكون بالروم أو الإشمام في الأحوال السابق بيانها.
و ضد الوقف الوصل، أي: وصل الكلمة بما بعدها دون تنفس، و يشبه الوقف السكت، و هو لغة: المنع، و اصطلاحا: قطع الكلمة عما بعدها مقدارا قصيرا من الزمن قدر حركتين دون تنفس، مع قصد العودة إلى القراءة في الحال.
و لا يكون إلا على ألف عِوَجاً و مَرْقَدِنا و نون مَنْ راقٍ، و لام (بل راق) اتفاقا، و بين الأنفال و براءة، و على هاء مالِيَهْ على أحد الأوجه الجائزة فيهما.
و لا يكون في غير تلك الكلمات و لا في وسط الكلمة أبدا، و يشبه الوقف أيضا القطع، أي: انتهاء القراءة.
و القطع لغة: الفصل و الإزالة. و اصطلاحا: قطع الكلمة عما بعدها مقدارا طويلا من الزمن مع التنفس دون قصد للعودة إلى القراءة في الحال، و لا يكون إلا في أواخر السور أو رءوس الآي على الأقل فإذا عاد القارئ
ص: 121
بعده إلى القراءة استحب له أن يستعيذ باللّه عملا بقوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ.
أقسام الوقف في ذاته و تعريف كل منها و وجه تسميته باسمه و حكمه:
اشارة
ثم إن الوقف ينقسم في ذاته إلى ثلاثة أقسام: اضطراري، و اختباري- بالباء الموحدة-، و اختياري- بالياء المثناة-.
فأما الوقف الاضطراري فهو: ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة ملجئة إليه كالعطاس و ضيق النفس.
و سمي اضطراريا: لأن سببه الضرورة و الاضطرار.
و حكمه: أنه يجوز للقارئ الوقف على أية كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعته إليه، ثم يعود إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها و يصلها بما بعدها و يستمر في قراءته إذا صلح الابتداء بما وقف عليه، و إلا فبما قبله مما يصلح الابتداء به.
و أما الوقف الاختباري: فهو أن يقف القارئ على كلمة ليست محلا للوقف عادة في مقام التعليم لبيان حكمها من حيث القطع و الوصل و الحذف و الإثبات، و نحو هذا، أو للإجابة على سؤال طلب إليه به بيان شي ء من ذلك، و سمي اختباريا: لحصوله في بعض أحواله إجابة على اختبار.
و حكمه: الجواز على أن يعود إلى ما وقف عليه فيبتدئ به و يصله بغيره مما بعده و يستمر في قراءته إن صلح الابتداء بما وقف عليه، و إلا فبما قبله مما يصلح الابتداء به كالوقف الاضطراري تماما.
و أما الوقف الاختياري: فهو أن يقف القارئ على كلمة باختياره دون عروض ضرورة ملجئة للوقف، و لا تعليم حكم من الأحكام، و لا إجابة على سؤال يتطلبه.
و سمي اختياريا: لحصوله بمحض اختيار القارئ دون ضرورة و لا إجابة على اختبار.
ص: 122
و حكمه: أنه قد يعود إلى الابتداء بما وقف عليه فيصله بما بعده أو يبتدئ بما بعد الكلمة التي وقف عليها على ما سيأتي بيانه تفصيلا.
أقسام الوقف الاختياري:
اشارة
ثم إن الوقف الاختياري ينقسم إلى أربعة أقسام: تام، و كاف، و حسن، و قبيح. لأنه إما أن يتم الكلام في ذاته و لا يتعلق بما بعده لفظا و لا معنى، فهو التام. و إما أن يتم الكلام في ذاته و يتعلق بما بعده معنى لا لفظا فهو الكافي، و إما أن يتم الكلام في ذاته و يتعلق بما بعده لفظا و معنى فهو الحسن.
و إما ألا يتم الكلام في ذاته فهو القبيح، و إما أن يتم الكلام و يتعلق بما بعده لفظا لا معنى و هو الصورة العقلية التي لم تذكر فلا وجود لها في الواقع إذ لا يوجد كلام متعلق بما بعده في اللفظ دون المعنى، لأن تعلق الكلام بما بعده في اللفظ يقتضي تعلقه به في المعنى من باب أولى.
و المراد بالتعلق في المعنى معروف، و هو ما يرجع فيه إلى علم التفسير و البلاغة و نحوهما. و المراد بالتعلق في اللفظ، التعلق الإعرابي الذي يرجع فيه إلى القواعد النحوية، و إليك بيان أنواع الوقف الاختياري بالتفصيل فيما يلي:
تعريف الوقف التام و وجه تسميته تامّا و صوره و حكمه:
أما الوقف التام فهو: الوقف على كلام تام في ذاته غير متعلق بما بعده لفظا و لا معنى، و سمي تاما لتمام الكلام به و استغنائه عما بعده، و يوجد غالبا في أواخر السور، و أواخر القصص، كالوقف على الرحيم من قوله تعالى:
وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ في مواضعها الثمانية بالشعراء (1) لانتهاء الكلام عندها عن قصة و البدء في قصة أخرى، و عند انقطاع الكلام على موضوع معين للانتقال إلى غيره كالوقف على تَعْلَمُونَ من قوله تعالى:
ص: 123
1- وردت هذه الآيات في سورة الشعراء ثماني مرات و هي (9، 68، 104، 122، 140، 159، 175، 191).
وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بالبقرة؛ لأنه نهاية الكلام على أحكام الطلاق و ما بعده بدء في سرد أحكام أخرى.
و صوره أربع؛ لأنه قد يكون على رءوس الآي كالمثالين السابقين، أو قريبا من رأس الآية كالوقف على قوله تعالى: وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ بالبقرة، أو في وسط الآية، كالوقف على قوله تعالى: كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ بالأنعام، وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ بالنساء، و على قوله تعالى:
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ بالنساء أيضا؛ لأن هذا الجزء من الآية قد أنزل في وقت غير الذي أنزل فيه الجزء الآخر منها و هو: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا على ما ذكره النيسابوري، أو قريبا من أول الآية نحو: مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ، وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ، و هذا الوقف على كل حال هو أقل الوقوف الجائزة ورودا في القرآن الكريم بينما هو أعلاها مرتبة.
و حكمه: أنه يحسن الوقف عليه و الابتداء بما بعده.
تعريف الوقف الكافي و وجه تسميته كافيا و صوره و حكمه:
و أما الوقف الكافي فهو: الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. و سمي كافيا: للاكتفاء به، و استغنائه عما بعده و صوره أربع؛ لأنه قد يكون على رءوس الآي كالوقف على قوله تعالى: لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً أو قريبا من رأس الآية كالوقف على قوله تعالى: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ أو في وسط الآية كالوقف على قوله تعالى: فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ، لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي أو قريبا من أول الآية كالوقف على قوله تعالى: وَ عَلاماتٍ، وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً.
و حكمه أنه يحسن الوقف و الابتداء بما بعده كالتام و هو أكثر الوقوف الجائزة ورودا في القرآن الكريم، و قد يتفاوت مقدار كفايته، فالوقف على
ص: 124
قوله تعالى: وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ كاف، و الوقف على قوله: يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ أكثر كفاية منه، و الوقف على قوله تعالى: ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ أكثر كفاية منهما.
الفرق بين التام و الكافي:
ثم إن الفرق بين الوقف التام و الكافي غير محدد منضبط عند جميع القراء كالفرق بينهما و بين الحسن و القبيح؛ لأن وجه الاختلاف بين التام و الكافي تعلقه بما بعده في المعنى أولا، و هو أمر نسبي يرجع فيه إلى الأذواق في فهم المعاني و اعتبار ما وقف عليه متعلقا بما بعده في المعنى، أو مستغنيا عنه، و لذا نجد منهم من يعد بعض الوقوف الكافية في نظر غيره تامة أو العكس.
أما الفرق بين التام و الكافي و غيرهما من الوقوف فليس محلا لهذا الاختلاف الكبير؛ لأنه يعتمد على تعلق ما وقف عليه بما بعده في الإعراب أولا، و هو أمر منضبط بعض الشي ء أكثر من التعلق المعنوي.
تعريف الوقف الحسن و وجه تسميته حسنا و صوره و حكمه:
و أما الوقف الحسن فهو: الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في اللفظ و المعنى معا، كأن يكون متبوعا و ما بعده تابعا له، أو مستثنى منه و ما بعده مستثنى. و سمي حسنا؛ لأنه يحسن الوقف عليه، و صوره أربع: قد يكون على رءوس الآي كالوقف على المؤمنين من قول اللّه تعالى: وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ أو قريبا من رأس الآية كالوقف على قوله تعالى: قُمِ اللَّيْلَ أو في وسط الآية كالوقف على قوله تعالى: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ.
أو قريبا من أول الآية كالوقف على قوله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ أول فاطر.
و حكمه: أنه يحسن الوقف عليه، و لا يجوز الابتداء بما بعده إذا كان الوقف على رأس آية اتفاقا. و إنما يعود القارئ إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها و يصلها بما بعدها إن صلح الابتداء بها، و إلا فبما قبلها مما يصلح
ص: 125
الابتداء به.
و أما إذا كان الوقف على رأس آية فإنه يسن الوقف عليه كما تقدم، و لكن لا يجوز الابتداء بما بعده اتفاقا إلا بثلاثة شروط و هي:
1- ألا يوهم الوقف على رأس الآية، و الابتداء بما بعده خلاف المعنى المراد.
2- أن يفهم ما بعد رأس الآية الموقوف عليه معنى.
3- ألا يكون ما بعد رأس الآية تابعا لمتبوع في الآية التي وقف على رأسها، و ذلك كالوقف على: يُنْقَذُونَ من قوله تعالى: وَ لا هُمْ يُنْقَذُونَ و الابتداء بما بعده و هو: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا فإنه لا يوهم خلاف المعنى المراد، و يفهم مما بعده رأس الآية معنى، و ليس تابعا لمتبوع في الآية التي وقف على رأسها.
أما إذا كان الوقف على رأس الآية، و الابتداء بما بعده يوهم خلاف المعنى المراد كالوقف على قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فإنه يسن الوقف على رأس الآية، و لا يجوز الابتداء بما بعده اتفاقا، و إن كان ما بعد رأس الآية الموقوف عليه لا يفهم منه معنى إذا ابتدئ به كالوقف على قوله تعالى:
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ و الابتداء بما بعده و هو: فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ الذي لا يفيد معنى إلا إذا انضم إليه ما قبله، أو كان ما بعد رأس الآية الموقوف عليه تابعا لمتبوع من الآية الموقوف على رأسها نحو: صِراطَ الَّذِينَ فإنه بدل من الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ الموقوف عليه، فقد اختلف في جواز الابتداء بما بعد رأس الآية في كل من هاتين الحالتين أولا.
و الظاهر من كلام ابن الجزري- و هو ما أستريح إليه- جواز الابتداء بما بعد رأس الآية في هاتين الحالتين بصرف النظر عن كونه في إحداهما لا يهم منه معنى، و في الأخرى تابعا لمتبوع في الآية الموقوف على رأسها عملا بحديث تقطيع القراءة و الوقف على رءوس الآي و الابتداء بما بعدها.
ص: 126
تعريف الوقف القبيح و وجه تسميته قبيحا و صوره و حكمه:
و أما الوقف القبيح فهو: الوقف قبل أن يتم الكلام في ذاته كالوقف بين الفعل و فاعله، و المبتدأ و خبره، و المضاف و المضاف إليه، و نحو ذلك، و سمي قبيحا لقبح الوقف عليه؛ إلا لضرورة و صوره أربع؛ لأنه قد يكون على رءوس الآي، كالوقف علي قوله تعالى: إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ أو قريبا منه كالوقف على لفظ الجلالة من قوله: فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ أو في وسط الآية كالوقف على خير من قوله تعالى: وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ أو قريبا من أول الآية كالوقف على الحق من قوله تعالى: الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ.
و حكمه: أنه لا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة كضيق النفس، فإن وقف عليه ابتدئ بالكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها، و إلا فبما قبلها مما يصلح الابتداء به.
ص: 127
فوائد تتعلق بالوقف و الابتداء
1- حكم الوقف و الابتداء إذا أوهم أحدهما معنى شنيعا:
و من الغاية في القبيح الوقف الموهم معنى شنيعا كالوقف على قوله تعالى:
لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ أو بين النفي و الإيجاب كالوقف على قوله تعالى: وَ ما مِنْ إِلهٍ و كذلك الابتداء بما يوهم معنى شنيعا كالابتداء بقوله تعالى: غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ و حكم هذا النوع من الوقف و الابتداء التحريم على من تعمده فإن اعتقده كفر.
2- الوقف الشاذ الذي لا يجوز:
و من الوقوف المنصوص عليها في بعض الكتب ما يجب تجنبه لشذوذه نظرا إلى إيهامه خلاف المعنى المراد، و إن رآه بعض الناس مقبولا لعدم تأمل المعنى المقصود من الآية في جملتها، و ذلك كالوقف على قوله تعالى: قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ لا و هو شاذ لا يجوز.
3- بعض ما يصح الابتداء به و الوقف على ما قبله و ما لا يصح:
و يلاحظ أنه مما يحسن الابتداء به و الوقف على ما قبله غالبا لفظ (إنّ) بكسر الهمز و تشديد النون ما لم تقع بعد قول أو قسم في آيتها. و مما لا يصح الابتداء به و الوقف على ما قبله لفظ أن بفتح الهمز و تشديد النون، و لكن بالتخفيف، إلا أن تكون لكن أو لكن في بدء آية نحو قول اللّه تعالى: لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ و نحو: لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي.
4- هناك أنواع أخرى من الوقف منها:
وقف السنة: و يسمى وقف جبريل، و وقف الاتباع، و ذلك في عشرة مواضع في القرآن الكريم (1):
الموضعان الأول و الثاني: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ في سورتي البقرة و العقود.
ص: 128
1- معالم الاهتداء (13)
الثالث: قُلْ صَدَقَ اللَّهُ في آل عمران.
الرابع: ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ في العقود.
الخامس: قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ في يوسف.
السادس: كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ في الرعد.
السابع: وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها في النحل.
الثامن: أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً في السجدة.
التاسع: فَحَشَرَ في النازعات.
العاشر: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ في القدر.
و قد ذكر هذه المواضع الشيخ أحمد بن عبد الكريم الأشموني في كتابه المسمى «منار الهدى في بيان الوقف و الابتداء» نقلا عن الشيخ السخاوي، و زاد بعض ممن كتب في علم التجويد سبعة مواضع:
1- أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ.
2- وَ لا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ كلاهما بيونس.
3- إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ في النحل.
4- يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ في لقمان.
5- أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ في غافر.
6- مِنْ كُلِّ أَمْرٍ في القدر.
7- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ في النصر.
فتكون الجملة سبعة عشر موضعا، و سمي الوقف في هذه المواضع وقف السنة و وقف جبريل و وقف الاتباع؛ لأن الرسول صلى الله عليه و سلم كان يتحرى الوقف في هذه المواضع دائما. هكذا قالوا.
الوقف الصالح: و هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها تعلقا معنويّا، و تعلق بها أو بما قبلها تعلقا لفظيّا على الراجح، فلا بد من ثبوت التعلق المعنوي في الوقف الصالح أيضا، و أما التعلق اللفظي فيكون ثابتا فيه
ص: 129
أيضا على الراجح، و على هذا يتفق الوقفان الحسن و الصالح في ثبوت التعلق المعنوي فيهما. و يفترقان في التعلق اللفظي؛ لأنه يكون منفيا في الوقف الحسن على الراجح، و ثابتا في الوقف الصالح الراجح.
و بيان ذلك أن الجملة التي تلي الكلمة الموقوف عليها إذا كان فيها الوجهان السابقان في الوقف الحسن و لكن كان الوجه الثاني و هو أن للجملة موضعا من الإعراب لكونها في موضع الخبر أو الصفة أو الحال- إلى غير ذلك- راجحا على الوجه الأول و هو أن الجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب.
و إذا كانت الجملة هكذا فالوقف على الكلمة قبلها يسمى وقفا صالحا.
و الأفضل وصل هذه الكلمة بما بعدها نظرا للوجه الراجح و هو أن للجملة بعدها محلا من الإعراب، و يجوز الوقف عليها باعتبار الوجه المرجوح و هو استئناف الجملة بعدها؛ فيكون الوصل أرجح من الوقف.
و من أمثلة الوقف الصالح: الوقف على كلمة اهبطوا في قوله تعالى:
وَ قُلْنَا اهْبِطُوا [البقرة الآية: 36]، و ذلك أن جملة: بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ المكونة من مبتدأ و خبر فيها وجهان:
أصحهما- كما قاله العلامة السمين-: أنها في محل نصب على الحال من الواو في اهبطوا و التقدير متعادين.
و الثاني: أنها لا محل لها من الإعراب مستأنفة بقصد الإخبار بالعداوة فحينئذ يكون وصل اهبطوا بالجملة بعدها أفضل من الوقف عليها و إن كان جائزا.
و من أمثلته أيضا الوقف على كلمة و عَصَيْنا في قوله تعالى: قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا [البقرة آية: 93] و ذلك أن جملة و اشْرَبُوا يحتمل أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل قالوا بتقدير قد عند البصريين و من غير تقديرها عند الكوفيين و يحتمل أن تكون معطوفة على جملة قالوا، و يحتمل
ص: 130
أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب جي ء بها لمجرد الإخبار بذلك، و لكن هذا الوجه ضعفه النحوي الكبير أبو البقاء و علل ضعفه بأن قوله تعالى:
قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إلخ جواب لقولهم: سَمِعْنا وَ عَصَيْنا، فيحسن ألا يكون بينهما أجنبي، فحينئذ يحسن وصل (و عصينا) بما بعدها نظرا للوجهين الأولين و يجوز الوقف عليها نظرا لوجه الاستئناف و إن كان ضعيفا.
و سمي هذا الوقف صالحا لأن الكلمة صالحة للوقف عليها نظرا للوجه المرجوح و إن كان وصلها بما بعدها أفضل نظرا للوجه الراجح.
ص: 131
الكواكب الدرّيّة في نزول القرآن على سبعة أحرف
اشارة
الكواكب الدرّيّة في نزول القرآن على سبعة أحرف
تأليف محمّد بن علي بن خلف الحسيني المالكي الأزهري المعروف بالحدّاد المتوفى سنة 1357 ه
ص: 133
الكواكب الدرية فيما ورد في إنزال القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث النبوية و الأخبار المأثورة في بيان احتمال رسم المصاحف العثمانية للقراءات المشهورة و نصوص الأئمة الثقات في ضابط المتواتر من القراءات و ما يناسب ذلك تأليف العلامة الأوحد و العلم المفرد الشيخ: محمد الشهير بالحداد بن علي بن خلف الحسيني المالكي الأزهري شيخ القراء و المقارئ بالديار المصرية.
هذا كتاب قد بدا*** للقارئين محببا
فاقرأ أخي و لك ***و العلم فاطلب
ص: 134
[خطبة الكتاب]
بسم اللّه الرحمن الرحيم حمدا لمن بعث فينا أفضل رسول بأفضل كتاب، و صلاة و سلاما على من قطع دابر القوم الذين ظلموا و وصل من هداهم اللّه برب الأرباب و على آله الذين أجابوا دعوته و أصحابه الذين جمعوا القرآن في المصاحف بعد أن جمعوه في الصحف خشية الفرقة و الاختلاف، و خوفا عليه من الذهاب و بعد فيقول راجي العفو عما اقترف محمد بن علي بن خلف الحسيني المالكي الأزهري غفر اللّه له ذنوبه و ستر في الدارين عيوبه: هذه رسالة رتبتها على خمسة أبواب و خاتمة:
فالباب الأول: في الكلام عن حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف».
و الباب الثاني: في الكلام على سبب جمع القرآن و من جمعه.
و الباب الثالث: في الكلام على ما اشتملت عليه المصاحف العثمانية من القراءات.
و الباب الرابع: في الكلام على ما يجوز من القراءات، و ما لا يجوز.
و الباب الخامس: في الكلام على حكم اتباع رسم المصاحف العثمانية.
و الخاتمة في الكلام على الكتابة و أنواعها و حكمها و ثمرتها و أول من وضعها و ما يتعلق بذلك مما دعت الضرورة إلى ذكره و قضت الحاجة بنشره.
لخصتها من كتاب النشر لإمام المحققين شمس الملة و الدين محمد بن محمد الجزري و شرح العقيلة لعلم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي و شرحها لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري و شرح الشاطبية له و شرح مورد الظمآن للعلامة الأستاذ الكبير الشيخ محمد بن عثمان بن كيكي بن سعيد الطويسي و غير ذلك من الكتب النفيسة.
و قد اعتمدت في ذلك على السيد المالك إنه على كل شي ء قدير فنعم المولى و نعم النصير و سميتها «الكواكب الدرية» فيما ورد في نزول القرآن على
ص: 135
سبعة أحرف من الأحاديث النبوية و الأخبار المأثورة في بيان احتمال رسم المصاحف العثمانية للقراءات المشهورة و نصوص الأئمة الثقات في ضابط المتواتر من القراءات و ما يناسب ذلك و اللّه المسئول في نيل القبول و ها أنا ذا أشرع فأقول متوسلا بجاه الرسول (1).
ص: 136
1- و هذا من التوسل غير المشروع، و لا يصح فيه شي ء، و حديث: «توسلوا بجاهي» لا يصح عن نبينا عليه الصلاة و السلام. و عليه فلا يجوز التوسل بجاه النبي و لا بجاه أحد من الصالحين. و راجع التوسل للعلامة الألباني- رحمه اللّه-.
الباب الأول في الكلام على حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف و فيه ثمانية فصول
الفصل الأول في بيان طرقه
قد روي بالطرق الصحيحة عن جمع من الصحابة و تواتر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة فاقرءوا ما تيسر منه».
روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها؟ فقال: أقرأنيها رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، فقلت: كذبت فإن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، فقلت: إن هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «أرسله اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها فقال: «كذلك أنزلت» ثم قال: «اقرأ يا عمر» فقرأت القراءة التي أقرأنيها فقال: «كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه».
و في لفظ البخاري عن عمر أيضا: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول اللّه صلى الله عليه و سلم ... الحديث.
و في لفظ مسلم عن أبي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال: «إن اللّه يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف» فقال: «سل اللّه معافاته و معونته فإن أمتي لا تطيق ذلك»، ثم أتاه الثانية على حرفين فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة بثلاثة فقال لهم مثل ذلك، ثم أتاه الرابعة فقال: «إن
ص: 137
اللّه يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا» (1).
و في لفظ للترمذي أيضا: عن أبي قال: لقي رسول اللّه صلى الله عليه و سلم جبريل عند أحجار المروة قال: فقال رسول اللّه صلى الله عليه و سلم لجبريل: «إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني و العجوز و الكبير و الغلام» قال: «فليقرءوا على سبعة أحرف» (2).
و في لفظ حذيفة فقلت: «يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل و المرأة و الغلام و الجارية و الشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف».
و في لفظ لأبي هريرة: «أنزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما».
و في رواية لأبي: دخلت المسجد أصلي فدخل رجل فافتتح النحل فقرأ فخالفني في القراءة فلما انفتل (3) قلت: من أقرأك؟ قال: رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، ثم جاء رجل آخر فقام يصلي فقرأ فافتتح النحل، فخالفني و خالف صاحبي فلما انفتل قلت: من أقرأك؟ قال: رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، قال: فدخل في قلبي من الشك و التكذيب أشد مما كان في الجاهلية فأخذت بأيديهما و انطلقت بهما إلى رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، فقلت: استقرئ هذين، فاستقرأ أحدهما، فقال: «أحسنت» فدخل قلبي من الشك و التكذيب أشد مما كان في الجاهلية، ثم استقرأ الآخر فقال: «أحسنت» فدخل صدري من الشك و التكذيب أشد مما كان في الجاهلية فضرب رسول اللّه صلى الله عليه و سلم صدري بيده فقال: «أعيذك باللّه يا أبي منا.
ص: 138
1- رواه أبو داود و الترمذي و أحمد، و هذا لفظه مختصرا.
2- قال الترمذي: حسن صحيح، و في لفظ «فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ».
3- انفتل أي انتهى من صلاته و قراءته فيها.
الشك».
ثم قال: «إن جبريل- عليه السلام- أتاني فقال: إن ربك- عز و جل- يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: اللهم خفف عن أمتي، ثم عاد فقال: إن ربك- عز و جل- يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين. فقلت:
اللهم خفف عن أمتي، ثم عاد فقال: إن ربك- عز و جل- يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة و أعطاك بكل ردة مسألة» الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بهذا اللفظ، و في لفظ لابن مسعود: «فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى غيره رغبة عنه».
و في لفظ لأبي بكرة: «كل شاف كاف ما لم يختم آية عذاب برحمة و آية رحمة بعذاب» و هو كقولك: هلم و تعال و أقبل و أسرع و اذهب و اعجل.
و في لفظ لعمرو بن العاص: «فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم و لا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر».
و قد وقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام. فمن ذلك ما وقع لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل كما تقدم.
و منه ما أخرجه أحمد عن ابن قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو: إنما هي كذا و كذا، فذكر ذلك للنبي صلى اللّه صلى الله عليه و سلم فقال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا فيه» إسناده حسن.
و لأحمد أيضا و أبي عبيد و الطبراني من حديث أبي جهم بن الصمة أن رجلين اختلفا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فذكر نحو حديث عمرو بن العاص.
و للطبري و الطبراني عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت و أقرأنيها أبي بن كعب فاختلفت قراءتهم فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول اللّه صلى الله عليه و سلم و علي إلى جنبه
ص: 139
فقال علي: ليقرأ كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن جميل.
و لابن حبان و الحاكم من حديث ابن مسعود: أقرأني رسول اللّه صلى الله عليه و سلم سورة من آل حم فرحت إلى المسجد فقلت لرجل: اقرأها فإذا هو يقرأ حروفا ما أقرؤها، فقال: أقرأنيها رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فانطلقنا إلى رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فأخبرناه فتغير وجهه و قال: «إنما أهلك من كان من قبلكم الاختلاف» ثم أسر إلى علي شيئا فقال علي: إن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم، قال: فانطلقنا و كل رجل منا يقرأ حروفا لا يقرؤها صاحبه.
قال الإمام شمس الدين محمد بن الجزري في كتابه النشر: و قد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام- رحمه اللّه- على أن هذا الحديث تواتر عن النبي صلى الله عليه و سلم.
قلت: و قد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك فرويناه من حديث عمر بن الخطاب و هشام بن حكيم بن حزام و عبد الرحمن ابن عوف و أبي بن كعب و عبد اللّه بن مسعود و معاذ بن جبل و أبي هريرة و عبد اللّه بن عباس و أبي سعيد الخدري و حذيفة بن اليمان و أبي بكرة و عمرو ابن العاص و زيد بن أرقم و أنس بن مالك و سمرة بن جندب و عمرو بن أبي سلمة و أبي جهم و أبي طلحة الأنصاري و أم أيوب الأنصارية- رضي اللّه عنهم-.
و روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يوما و هو على المنبر: أذكر اللّه رجلا سمع النبي صلى الله عليه و سلم قال: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف» لما قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» فقال عثمان رضي الله عنه: و أنا أشهد معهم.
ص: 140
الفصل الثاني في بيان المراد بالأحرف السبعة
قال ابن الجزري: و قد اختلفت أقوال العلماء في المراد بهذه الأحرف السبعة على نحو من أربعين قولا مع إجماعهم على أنه ليس المراد بها قراءات سبعة من القراء كالسبعة المشهورين و إن كان يظن ذلك بعض العوام؛ لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقوا و لا وجدوا.
و أول من جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد في أثناء المائة الرابعة فلو كان الحديث منصرفا إلى قراءات السبعة المشهورين أو سبعة غيرهم من القراء الذين ولدوا بعد التابعين لأدى ذلك إلى أن يكون الخبر عاريا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء السبعة الأئمة فتؤخذ عنهم القراءة.
و أدى أيضا إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا و تعلموا اختاروا القراءة به و هذا باطل إذ طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة لفظا عن لفظ، إماما عن إمام، إلى أن يتصل بالنبي صلى الله عليه و سلم كما يأتي مبسوطا، و مع إجماعهم أيضا على أنه ليس المراد كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه إذ لا يوجد ذلك في كلمة من المشهور.
و أصح الأقوال و أولاها بالصواب و هو الذي عليه أكثر العلماء و صححه البيهقي و اختاره الأبهري و غيره و اقتصر عليه في القاموس: أن المراد بالأحرف أوجه من اللغات بمعنى أن القرآن لا يخرج عن سبع لغات من لغات العرب و هي لغة: قريش، و هذيل، و ثقيف، و هوازن، و كنانة، و تميم، و اليمن.
و ذلك أن الحرف لغة يطلق على الوجه، و منه قوله تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ قال الحافظ أبو عمرو الداني: معنى الأحرف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه و سلم هاهنا يتوجه إلى وجهين:
أحدهما: أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات لأن الأحرف جمع حرف في القليل كفلس و أفلس و الحرف قد يراد به الوجه
ص: 141
بدليل قول اللّه تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ الآية.
فالمراد بالحرف هنا الوجه أي على النعمة و الخير و إجابة السؤال و العافية فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن و عبد اللّه، و إذا تغيرت عليه و امتحنه اللّه بالشدة و الضر ترك العبادة و كفر، فهذا عبد اللّه على وجه واحد، فلهذا سمى النبي صلى الله عليه و سلم هذه الأوجه المختلفة من القراءات و المتغايرة من اللغات أحرفا على معنى أن كل شي ء منها وجه.
قال: و الوجه الثاني: أن يكون سمى القراءات أحرفا على طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم الشي ء باسم ما هو منه و ما قاربه و جاوره. و كان كسبب منه و تعلق به ضربا من التعلق؛ كتسميتهم الجملة باسم البعض منها، فلذلك سمى النبي صلى الله عليه و سلم القراءة حرفا و إن كانت كلاما كثيرا من أجل أن منها حرفا قد غير نظمه أو كسر أو قلب إلى غيره أو أميل أو زيد أو نقص منه على ما جاء في المختلف فيه من القرآن فسمى القراءة إذا كان ذلك الحرف منها حرفا على عادة العرب في ذلك و اعتمادا على استعمالها انتهى.
قال الشمس بن الجزري: و كلا الوجهين محتمل؛ إلا أن الأول محتمل احتمالا قويا في قوله صلى الله عليه و سلم: «سبعة أحرف» أي: سبعة أوجه و أنحاء، و الثاني محتمل احتمالا قويا في قول عمر رضي الله عنه: سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللّه صلى الله عليه و سلم- أي: على قراءات كثيرة-، و كذا قوله في الرواية الأخرى: سمعته يقرأ أحرفا لم يكن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أقرأنيها انتهى.
ص: 142
الفصل الثالث في ترجيح أن المراد بالأحرف أوجه اللغات
و مما يؤيد أن المراد بالأحرف أوجه من اللغات أن حكمة إتيان القرآن على سبعة أحرف التخفيف و التيسير على هذه الأمة في التكلم بكتابهم كما خفف عليهم في شريعتهم و هو كالمصرح به في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه و سلم: «أسأل اللّه معافاته و معونته» و كقوله: «إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف واحد فرددت إليه أن هون على أمتي» و لم يزل يردد حتى بلغ سبعة أحرف.
و كقوله لجبريل: «إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل و المرأة و الغلام و الجارية و الشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط».
و ذلك أنه صلى الله عليه و سلم أرسل للخلق كافة و ألسنتهم مختلفة غاية الاختلاف كما هو مشاهد فينا و من كان قبلنا مثلنا و كلهم مخاطب بقراءة القرآن قال تعالى:
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فلو كلفوا كلهم النطق بلغة واحدة لشق ذلك عليهم و تعسروا، إذ لا قدرة لهم على ترك ما اعتادوا و ألفوه من الكلام إلا بتعب شديد و جهد جهيد و ربما لا يستطيعه بعضهم و لو مع الرياضة الطويلة و تذليل اللسان، كالشيخ و المرأة، فاقتضى يسر الدين أن يكون القرآن على لغات.
ص: 143
الفصل الرابع في بيان سبب ورود القرآن على سبعة أحرف
قال المحقق ابن الجزري: فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة و إرادة اليسر بها و التهوين عليها شرفا لها و توسعة و رحمة و خصوصية لفضلها و إجابة لقصد نبيها أفضل الخلق و حبيب الحق، حيث أتاه جبريل فقال: «إن اللّه يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف» فقال صلى الله عليه و سلم:
«سل اللّه معافاته و معونته إن أمتي لا تطيق ذلك» و لم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف.
و في الصحيح أيضا: «إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي» و لم يزل حتى بلغ سبعة أحرف، و كما ثبت صحيحا أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، و أن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد، و ذلك أن الأنبياء- عليهم الصلاة و السلام- كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم و النبي صلى الله عليه و سلم بعث إلى جميع الخلق أحمرهم و أسودهم و عربيهم و عجميهم، و كان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة و ألسنتهم شتى، و يعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها أو من حرف إلى آخر، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك و لو بالتعليم و العلاج لا سيما الشيخ و المرأة، و من لم يقرأ كتابا كما أشار إليه صلى الله عليه و سلم، فلو كلفوا العدول عن لغتهم و الانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع و ما عسى أن يتكلف المتكلف و تأبى الطباع انتهى.
و قال الإمام أبو محمد عبد اللّه بن قتيبة في كتاب المشكل: فكان من تيسير اللّه- تعالى- أن أمر نبيه صلى الله عليه و سلم بأن يقرئ كل أمة بلغتهم و ما جرت به عاداتهم.
قال العلامة ابن الجزري و هذا يقرأ: عَلَيْهِمْ و فِيهِمْ بضم الهاء، و الآخر يقرأ: عَلَيْهِمْ و مِنْهُمْ بالصلة، و هذا يقرأ: قَدْ أَفْلَحَ
ص: 144
و قُلْ أُوحِيَ و خَلَوْا إِلى بالنقل، و الآخر يقرأ: مُوسى و عِيسَى و الدُّنْيا بالإمالة، و غيره يلطف، و هذا يقرأ خَبِيراً و بَصِيراً بترقيق الراء، و الآخر يقرأ الصَّلاةَ و الطَّلاقَ بالتفخيم إلى غير ذلك انتهى.
قال ابن قتيبة: و لو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته و ما جرى عليهم اعتياده طفلا و يافعا و كهلا لاشتد ذلك عليه و عظمت المحنة فيه، و لا يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة و تذليل اللسان و قطع للعادة، فأراد اللّه برحمته و لطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات و متصرفا في الحركات كتيسيره عليهم في الدين انتهى.
و أيضا النبي تحدى بالقرآن جميع الخلق، قال تعالى: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ الآية فلو أتى بلغة دون لغة؛ لقال الذين لم يأت بلغتهم: لو أتى بلغتنا لأتينا بمثله و تطرق الكذب إلى قوله تعالى، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا.
ص: 145
الفصل الخامس في بيان اختلاف الأحرف السبعة اختلاف تنوع و تغاير لا اختلاف تضاد و تناقض
ثم اعلم- يرحمك اللّه- أن اختلاف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليها من النبي صلى الله عليه و سلم اختلاف تنوع و تغاير لا اختلاف تضاد و تناقض فإن هذا محال أن يكون في كلام اللّه تعالى، قال تعالى: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (1).
قال الإمام ابن الجزري: و قد تدبرنا اختلاف القراءات فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال:
أحدها: اختلاف اللفظ لا المعنى.
و الثاني: اختلافهما مع جواز اجتماعهما في شي ء واحد.
و الثالث: اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شي ء واحد بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد.
فأما الأول فكالاختلاف في: الصراط و عليهم و يؤده و القدس و يحسب و نحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط.
و أما الثاني فنحو: مالك و ملك في الفاتحة، لأن المراد في القراءتين هو اللّه تعالى لأنه مالك يوم الدين و ملكه و كذا: يكذبون و يكذبون؛ لأن المراد بهم هم المنافقون؛ لأنهم يكذبون بالنبي صلى الله عليه و سلم و يكذبون في أخبارهم.
و كذا: ننشزها- بالراء و الزاي-؛ لأن المراد بها هي العظام، و ذلك أن اللّه تعالى أنشرها أي: أحياها، و أنشزها أي: رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت، فضمّن اللّه المعنيين في القراءتين.
و أما الثالث: فنحو: وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا بالتشديد و التخفيف،
ص: 146
1- سورة النساء: 82.
و كذا: وَ إِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ بفتح اللام الأولى و رفع الأخرى و بكسر الأولى و فتح الثانية، و كذا: لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا بالتسمية و التجهيل، و كذا: لَقَدْ عَلِمْتَ بضم التاء و فتحها، و كذا ما قرئ شاذّا: وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ عكس القراءة المشهورة، و كذا يُطْعِمُ على التسمية فيهما، فإن ذلك كله و إن اختلف لفظا و معنى و امتنع اجتماعه في شي ء واحد فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد و التناقض، فأما وجه تشديد كَذَّبُوا فالمعنى: و تيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم.
و وجه التخفيف أي: و توهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به، فالظن في الأولى يقين و الضمائر الثلاثة للرسل، و الظن في القراءة الثانية شك و الضمائر الثلاثة للمرسل إليهم.
و أما وجه فتح اللام الأولى و رفع الثانية من: لِتَزُولَ فهو أن يكون إن مخففة من الثقيلة و إن مكرهم كامن الشدة، بحيث تقتلع منه الجبال الراسيات من مواضعها.
و في القراءة الثانية إن نافية أي: ما كان مكرهم و إن تعاظم و تفاقم ليزول منه أمر محمد صلى الله عليه و سلم و دين الإسلام، ففي الأولى تكون الجبال حقيقة، و في الثانية مجازا.
و أما الوجه: مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا على التجهيل فهو أن الضمير يعود للذين هاجروا، و في التسمية يعود إلى الخاسرين.
و أما وجه ضم تاء: عَلِمْتَ فإنه أسند العلم إلى موسى حديثا منه لفرعون حيث قال: إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ فقال: لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِرَ، فأخبر موسى- عليه السلام- عن نفسه بالعلم بذلك، أي أن العالم بذلك ليس مجنونا.
و قراءة فتح التاء أنه أسند هذا العلم إلى فرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد عمله.
ص: 147
و كذلك وجه قراءة الجماعة يُطْعِمُ بالتسمية وَ لا يُطْعَمُ على التجهيل أن الضمير في و هو يعود إلى اللّه تعالى، أي: و اللّه تعالى يرزق الخلائق و لا يرزقه أحد.
و الضمير في عكس هذه القراءة يعود إلى الولي، أي: و الولي المتخذ يرزق و لا يرزق أحدا.
و الضمير في القراءة الثالثة يعود إلى اللّه تعالى، أي: و اللّه يطعم من يشاء و لا يطعم من يشاء فليس في شي ء من القراءات تناف و لا تضاد و لا تناقض.
و كل ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك فقد وجب قبوله و لم يسع أحدا من الأمة رده و لزم الإيمان به و أنه كله منزل من عند اللّه إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها و اتباع ما تضمنته من المعنى علما و عملا، و لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنّا أن ذلك تعارض.
و إلى ذلك أشار عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه بقوله: لا تختلفوا في القرآن و لا تنازعوا فيه فإنه لا يختلف و لا يتساقط، أ لا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة حدودها و قراءتها، و أمر اللّه فيها واحد، و لو كان من الحرفين حرف يأمر بشي ء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف و لكنه جامع ذلك كله و من قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله.
قلت: و إلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال لأحد المختلفين: «أحسنت»، و في الحديث الآخر: «أصبت»، و في الآخر: «هكذا أنزلت»، فصوب النبي صلى الله عليه و سلم قراءة كل من المختلفين و قطع بأنها كذلك أنزلت من عند اللّه و بهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء، فإن اختلاف القراءة كله حق و صواب نزل من عند اللّه و هو كلامه و لا شك فيه.
و اختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي و الحق في نفس الأمر فيه واحد فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ.
ص: 148
و كل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق و صواب في نفس الأمر نقطع بذلك و نؤمن به و نعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة و غيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له و أكثر قراءة و إقراء به و ملازمة له و ميلا إليه لا غير ذلك، و كذلك إضافة الحروف و القراءات إلى أئمة الإقراء و رواتهم المراد بها أن ذلك القارئ و ذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به فآثره على غيره و دام عليه و لزمه حتى اشتهر و عرف به و قصد فيه و أخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء.
و هذه الإضافة إضافة اختيار و دوام و لزوم لا إضافة اختراع و رأي و اجتهاد. انتهى من النشر.
و بهذا يندفع ما عساه أن يقال بين الحديث و الآية تناف فإن قوله عليه الصلاة و السلام لكل من المختلفين: «هكذا أنزلت»، أثبت الخلاف و قوله تعالى: وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً نفاه
ص: 149
الفصل السادس في بيان فوائد اختلاف القراءات
ثم اعلم- يرحمك اللّه- أن في اختلاف القراءات و تنوعها مع السلامة من التضاد و التناقض فوائد غير ما تقدم من التهوين و التسهيل و التخفيف على الأمة، منها بيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص و غيره: «و له أخ أو أخت من أم» فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هم الإخوة للأم.
و هذا أمر مجمع عليه و لذلك اختلف العلماء في المسألة المشتركة و هي زوج و أم أو جدة و اثنان من إخوة الأم و واحد أو أكثر من إخوة الأب و الأم.
فقال الأكثرون من الصحابة و غيرهم بالتشريك بين الإخوة لأنهم من أم واحدة، و هذا من مذهب مالك، و الشافعي، و إسحاق و غيرهم.
و قال جماعة من الصحابة و غيرهم: يجعل الثلث لإخوة الأم و لا شي ء لإخوة الأبوين لظاهر القراءة الصحيحة و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه الثلاثة و أحمد بن حنبل و داود الظاهري و غيرهم.
و منها ترجيح حكم اختلف فيه كقراءة: أو تحرير رقبة مؤمنة في كفارة اليمين ففيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي و غيره و لم يشترطه أبو حنيفة- رحمه اللّه-.
و منها الجمع بين حكمين مختلفين كقراءة: يَطْهُرْنَ و يَطْهُرْنَ بالتخفيف و التشديد فينبغي الجمع بينهما و هو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها و تطهر بالاغتسال.
و منها اختلاف حكمين شرعيين كقراءة: وَ أَرْجُلَكُمْ بالخفض و النصب فإن الخفض يقتضي فرض المسح و النصب يقتضي فرض الغسل فبينهما النبي صلى الله عليه و سلم فجعل المسح للابس الخف و الغسل لغيره، و من ثم و هم الزمخشري حيث حمل اختلاف القراءتين في: إِلَّا امْرَأَتَكَ رفعا و نصبا على اختلاف قولي المفسرين.
ص: 150
و منها إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة: (فامضوا إلى ذكر اللّه) فإن قراءة فَاسْعَوْا يقتضي ظاهرها المشي السريع و ليس كذلك، فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك و رافعة لما يتوهم منه.
و منها تفسير ما لعله لا يعرف مثل قراءة: (كالصوف المنقوش).
و منها ما هو حجة لأهل الحق و دفع لأهل الزيغ كقراءة وَ مُلْكاً كَبِيراً بكسر اللام وردت عن ابن كثير و غيره و هي من أعظم دليل على رؤية اللّه- تعالى- في الدار الآخرة.
و منها ما هو حجة لترجيح قول بعض العلماء كقراءة: (أو لمستم النساء) إذ اللمس يطلق على الحبس و المس كقوله تعالى: فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ أي مسوه، و منه قوله صلى الله عليه و سلم: «لعلك قبلت أو لامست» و منه قول الشاعر:
لمست بكفي أبتغي الغني و لم أدر أن الجود من كفه يعدي
فلا أنا منه ما أفاد ذوي الغنى أفدت و أعداني فأتلف ما عندي
و منها ما هو حجة لقول بعض أهل العربية كقراءة وَ الْأَرْحامَ بالخفض، و لِيَجْزِيَ قَوْماً على ما لم يسم فاعله مع النصب.
و منها ما في ذلك من نهاية البلاغة و كمال الإعجاز و غاية الاختصار و جمال الإيجاز إذ كل قراءة بمنزلة الآية، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام آيات، و لو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل و منها ما فيه من عظيم البرهان و واضح الدلالة.
إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف و تنوعه لم يتطرق إليه تضاد و لا تناقض و لا يتخالف بل كله يصدق بعضه بعضا و يبين بعضه بعضا و يشهد بعضه لبعض على نمط واحد و أسلوب واحد.
و ما ذلك إلا آية بالغة و برهان قاطع على صدق من جاء به صلى الله عليه و سلم.
و منها سهولة حفظه و تيسير نقله على هذه الأمة إذ هو على هذه الصفة من البلاغة و الرجازة فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه و أقرب إلى
ص: 151
فهمه و أدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات لا سيما فيما كان خطه واحدا فإن ذلك أسهل حفظا و أيسر لفظا.
و منها إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك و استنباط الحكم و الأحكام من دلالة كل لفظ و استخراج كمين أسراره و خفي إشاراته و إنعامهم النظر و إمعانهم الكشف عن التوجيه و التعليل و الترجيح و التفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم و يصل إليه نهاية فهمهم: فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى و الأجر على قدر المشقة.
و منها بيان فضل هذه الأمة و شرفها على سائر الأمم من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي و إقبالهم عليه هذا الإقبال و البحث عن لفظه، و بيان صوابه و تحرير تصحيحه و إتقان تجويده حتى حموه من خلل التحريف و حفظوه من الطغيان و التطفيف فلم يهملوا تحريكا و لا تسكينا و لا تفخيما و لا ترقيقا حتى ضبطوه مقادير المدات و تفاوت الإمالات و ميزوا بين الحروف بالصفات مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم و لم يصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم.
و منها إسنادها كتاب ربها و اتصال هذا السند الإلهي بسندها خصيصة اللّه لهذه الأمة المحمدية و إعظاما لقدر أهل هذه الملة الحنيفية.
فكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى أصله و يرفع ارتياب الملحد قطعا بوصله.
فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت، و لو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت.
و منها ظهور سر اللّه- تعالى- في توليه حفظ كتابه العزيز و صيانة كلامه المنزل بأوفى البيان و التمييز.
فإن اللّه تعالى لم يخل عصرا من الأعصار و لو في قطر من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب اللّه- تعالى- و إتقان حروفه و رواياته و تصحيح
ص: 152
وجوهه و قراءاته يكون سببا لوجود هذا السبب القويم على ممر الدهور و بقائه دليلا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف و الصدور و قد خص اللّه- تعالى- هذه الأمة في كتابهم هذا المنزل على نبيهم صلى الله عليه و سلم بما لم يكن لأمة من الأمم في كتبها المنزلة فإنه- سبحانه و تعالى- تكفل بحفظه دون سائر الكتب و لم يكل حفظه إلينا قال تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ و ذلك إعظام لأعظم معجزات النبي محمد صلى الله عليه و سلم لأن اللّه- تعالى- تحدى بسورة منه أفصح العرب لسانا، و أعظمهم عنادا و عتوا و إنكارا، فلم يقدروا على أن يأتوا بآية مثله ثم لم يزل يتلى آناء الليل و آناء النهار مع كثرة الملحدين و أعداء الدين، و لم يستطع أحد منهم معارضة شي ء منه و أي دليل على صدق نبوته صلى الله عليه و سلم أعظم من هذا.
و أيضا فإن علماء هذه الأمة لم تزل من الصدر الأول لآخر وقت تستنبط منه من الأدلة و الحجج و البراهين و الحكم و غيرها ما لم يطلع عليه متقدم و لا ينحصر لمتأخر.
بل هو البحر المحيط العظيم الذي لا قرار له ينتهى إليه و لا حدّ له يوقف عليه و من ثم لم تحتج هذه الأمة إلى نبي بعد نبيها صلى الله عليه و سلم كما كانت الأمم قبل ذلك لم يخل زمان من أزمنتهم عن أنبياء يحكمون أحكام كتابهم و يهدونهم إلى ما ينفعهم في عاجلهم و مآبهم.
قال اللّه تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ (1) فوكل حفظ التوراة إليهم، و لهذا دخلها بعد أنبيائهم التحريف و التبديل.).
ص: 153
1- سورة المائدة الآية (44).
و لما تكفل اللّه بحفظه خص به من شاء من بريته و أورثه من اصطفاه من خليقته قال تعالى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا (1).
و قال صلى الله عليه و سلم: «إن للّه أهلين من الناس»، قيل من هم يا رسول اللّه؟ قال:
«أهل القرآن هم أهل اللّه و خاصته» (2)
ص: 154
1- سورة فاطر الآية (32).
2- رواه ابن ماجة و أحمد و الدارمي و غيرهم من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات.
الفصل السابع في بيان ما يعتمد عليه في نقل القرآن و أنه جمع كله في حياة النبي صلى الله عليه و سلم
قال الإمام ابن الجزري: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب و الصدور لا على خط المصاحف و الكتب و هذه أشرف خصيصة من اللّه تعالى لهذه الأمة ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
«إن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم، فقلت له: أي ربي إذن يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال: إني مبتليك و مبتل بك و منزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرؤه نائما و يقظان، فابعث جندا أبعث مثلهم، و قاتل بمن أطاعك من عصاك و أنفق ينفق عليك».
فأخبر- تعالى- أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل يقرأ في كل حال كما جاء في صفة أمته: أناجيلهم في صدورهم، و ذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظون إلا في الكتب و لا يقرءونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب.
و لما خص اللّه- تعالى- بحفظه من شاء من عباده، أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه و بذلوا أنفسهم في إتقانه و تلقوه من النبي صلى الله عليه و سلم حرفا حرفا لم يهملوا منه حركة و لا سكونا و لا إثباتا و لا حذفا و لا دخل عليهم في شي ء من شك و لا وهم، و كان منهم من حفظه كله و منهم من حفظ أكثره و منهم من حفظ بعضه، كل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه و سلم كما يأتي مبسوطا إن شاء اللّه تعالى، و إلى هذا أشار الشاطبي في العقيلة بقوله:
و لم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول اللّه منذرا
يعني أن القرآن ما زال محفوظا مشهورا بين الصحابة- رضي اللّه عنهم- في أول حياة رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فما بعد ذلك فقد كان حفظه و دراسته و شهرته و جمعه قديما، و ليس ذلك بحادث فيما بعد كما زعم الملحدون، فإن الصحابة
ص: 155
- رضي اللّه عنهم- كان دأبهم من أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه و سلم إلى آخره الاهتمام و المسارعة إلى حفظ القرآن و تصحيحه و تجويده و تتبع وجوه قراءته، و لم يزل رسول اللّه صلى الله عليه و سلم عاملا بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ حريصا على تعليمه مجتهدا في نشره باعثا به الحفاظ إلى من لم يحضره.
بعث مصعب بن عمير و ابن أم مكتوم إلى المدينة قبل الهجرة لتعليم القرآن، و أرسل معاذ بن جبل إلى مكة بعد الفتح للإقراء.
و أمره اللّه- تعالى- أن يقرأ على أبي ليسمع ألفاظه فيعلمها الناس، و قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه و سلم إلى رجل منا يعلمه القرآن، و كان يسمع لمسجد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم بخفض أصواتهم لئلا يتغالطوا.
ص: 156
الفصل الثامن في بيان من جمع القرآن من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه و سلم
قال ابن الجزري: فالصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة رسول اللّه صلى الله عليه و سلم كانوا جمّا غفيرا أغناهم اهتمامهم بحفظه و كثرتهم عن جمعه بين الدفتين، منهم: أبو بكر، و عمر، و عثمان، و علي، و طلحة، و سعد، و ابن مسعود، و حذيفة، و سالم مولى أبي حذيفة، و أبو هريرة، و ابن عباس، و عمرو بن العاص و ابنه عبد اللّه، و معاوية، و ابن الزبير، و عبد اللّه بن السائب، و عائشة، و حفصة، و أم سلمة، و هؤلاء كلهم المهاجرون، و من الأنصار: أبي بن كعب، و معاذ بن جبل، و زيد بن ثابت، و أبو الدرداء، و مجمع بن حارثة، و أنس بن مالك، و أبو زيد الذي سئل عنه أنس فقال: أحد عمومتي.
قال النويري- رحمه اللّه- في شرحه على الطيبة: فإن قلت إذا كان هؤلاء كلهم جمعوا القرآن على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فكيف الجمع بين هذا و بين قول أنس رضي الله عنه: جمع القرآن على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أربعة، و في رواية عنه: لم يجمعه إلا أربعة: أبي، و معاذ، و زيد بن ثابت، و أبو زيد.
و في رواية أخرى: و أبو الدرداء، قلت: أما الرواية الأولى فلا تنافيه لعدم الحصر فيها، و أما الرواية الثانية فلا يصح حملها على ظاهرها لانتقاضها بمن ذكر فلا بد من تأويلها بأنه لم يجمعه بوجوه قراءاته، أو لم يجمعه تلقيا عن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم- أي: مشافهة منه صلى الله عليه و سلم- أو لم يجمعه عنده شيئا بعد شي ء كلما نزل حتى تكامل نزوله إلا هؤلاء انتهى.
و لعله إنما قصد بتأويل حديث أنس و دفع التنافي الظاهري بينه و بين ما ذكر مجرد بيان الواقع لا دفع ما عساه أن يقال: كيف يحصل التواتر على رواية الحصر في حديث أنس المذكور؟
و قد قطع القاضي أبو بكر بعدم ثبوته بالأربعة و توقف في الخمسة، لأن
ص: 157
الصحيح أن شرط التواتر مجرد عدد يفيد العلم بلا تعيين خلافا لمن عينه ستة أو اثني عشر، أو عشرين، أو أربعين، أو سبعين، و هو على الرواية المذكورة متحقق بلا نزاع، فإن الصحابة الذين هم الغاية القصوى في الذكاء و الفطنة بمكان من العدالة و الثقة، و كانت الصحابة- رضي اللّه عنهم- يكتبون آيات القرآن في الرقاع- جمع رقعة بالضم- و هي الخرقة و القطعة من الأدم، و الأكتاف جمع كتف، و المراد عظمه المنبسط كاللوح، و الأضلاع جمع ضلع- بكسر الضاد- و اللام تفتح في لغة الحجاز و تسكن في لغة تميم، و الأضلاع عظام الجنين، و العسب جمع عسيب، و هو الأصل العريض من جريد النخل، و اللخاف جمع لخفة كصحاف و صحفة الحجر العريض الأبيض، و كانوا يكتبون في هذه الأشياء و نحوها لأن الورق لم يكن حينئذ، و يؤيده ما روي أنه لما نزل قوله تعالى: لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ... وَ الْمُجاهِدُونَ فقال ابن أم مكتوم و عبد اللّه بن جحش: يا رسول اللّه، إنا أعميان فهل لنا رخصة فأنزل اللّه تعالى: غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ قال رسول اللّه: «ايتوني بالكتف و الدواة» و أمر زيدا أن يكتبها فكتبها، فقال زيد: كأني أنظر إلى موضعها عند صدع في الكتف.
و ما روي أن عثمان بعث إلى أبي بن كعب- رضي اللّه عنهما- بكتف شاة مكتوب عليها بعض قرآن ليصلح بعض حروفه.
و في بعض روايات البخاري: أن النبي صلى الله عليه و سلم قبل موته بأربعة أيام و كان ذلك يوم خميس قال لهم: «ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعدي»، و كان النبي صلى الله عليه و سلم كل سنة من رمضان يعرض ما معه من القرآن على جبريل- عليه السلام-، و كلما زاده حرفا من الأحرف السبعة أو نسخ منه شيئا بادر إلى حفظ ذلك و العمل بمقتضاه.
قال ابن عباس- رضي اللّه عنهما-: كان رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أجود الناس بالخير و كان أجود ما يكون في رمضان، لأن الروح الأمين كان يلقاه في كل
ص: 158
ليلة من رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه القرآن، و كان إذا لقيه أجود بالخير من الريح المرسلة.
و روي أنه صلى الله عليه و سلم عرضه في العام الأخير مرتين.
قالت عائشة و فاطمة- رضي اللّه عنهما-: سمعنا رسول اللّه صلى الله عليه و سلم يقول:
«إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة و إنه عارضني العام مرتين، و لا أراه إلا حضر أجلي» و إلى ذلك أشار الشاطبي في العقيلة بقوله:
و كل عام على جبريل يعرضه و قيل آخر عام عرضتين قرا
فعلم مما تقدم أن القرآن العزيز كان مجموعا كله في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم، و لكن لم يكن مجموعا في مصحف بل كان محفوظا في صدور الرجال و لم يجمعه صلى الله عليه و سلم في مصحف لما كان يترقبه من ورود زيادة و ناسخ لبعض المتلو، و لما تقدم أن اهتمام الصحابة- رضي اللّه تعالى عنهم- بحفظه و كثرة الحفاظ أغناهم عن ذلك.
ص: 159
الباب الثاني في الكلام على سبب جمع القرآن و من جمعه و فيه فصلان
الفصل الأول في بيان سبب الجمع و أن زيدا جمع القرآن كله بجميع وجوه قراءاته في زمن أبي بكر الصديق- رضي اللّه عنهما-
و لما أمن توقع النسخ لانقضاء الترول بوفاة الرسول صلى الله عليه و سلم و اقتضت المصلحة جمعه، و ألهم اللّه الخلفاء الراشدين لذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية- زادها اللّه تعالى شرفا-.
فكان ابتداؤه على يد أبي بكر الصديق بمشورة عمر الفاروق- رضي اللّه عنهما- فجمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحف و كانت هذه الصحف عند أبي بكر حتى مات ثم عند عمر حتى مات ثم عند حفصة حتى ماتت.
قال الحافظ بن حجر: و إنما كانت عند حفصة- رضي اللّه عنها- لأنها كانت وصية عمر فاستمر ما كان عنده عندها حتى طلبه منها من له طلب ذلك انتهى.
قال ابن الباقلاني: و كان الذي فعله أبو بكر فرض كفاية بدلالة قوله صلى الله عليه و سلم: «لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن» مع قوله تعالى: إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ إلى أن قال: و كان ذلك من النصيحة للّه و رسوله و كتابه و أئمة المسلمين و عامتهم.
و ذلك أن مسيلمة الكذاب الذي كان من قصته أنه لما سمع بأمر رسول اللّه صلى الله عليه و سلم و هو بمكة يدعو إلى اللّه- عز و جل- ادعى النبوة و بعث إلى النبي صلى الله عليه و سلم من يخبره بأحواله فكان ينقل إليه ما يسمع من النبي صلى الله عليه و سلم و غيره و كان يقرأ ما ينقل إليه من القرآن على من عنده من أهل اليمامة و يزعم أنه أنزل عليه.
ص: 160
و لما سمع ذكر الرحمن سمى نفسه الرحمن، فلما اشتهر القرآن عن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم و لم يمكنه دعواه أخذ يصنع قرآنا في زعمه فجاء يهجر و يخلط إلى آخر ما هو معلوم و مشهور عنه.
و كان يعرف في السحر و كان دميم الخلقة أصيف أخينس بعكس صفة الرسول صلى الله عليه و سلم، و كان أشد الناس عداوة للقراء.
و لما توفي رسول اللّه صلى الله عليه و سلم و اتصل بربه و ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة من بعده و سولت لمسيلمة الكذاب نفسه الأمارة بالسوء أن أكاذيبه تتبع و خرافاته تستمع، فاستهوى أهل اليمامة و هم بنو حنيفة بمخاريفه و أضلهم بأباطيله فارتدوا، فلما ظهر لأبي بكر رضي الله عنه من تماديه و من تعديه ما كان سبب هلاكه و ترديه، جهز إليه من المسلمين جيشا عدده أربعة آلاف فارس و أمر عليهم سيف اللّه خالد بن الوليد فسار إليه و التقت الفئتان، و تأخر الفتح و استشهد جماعة من المسلمين منهم زيد بن الخطاب أخو سيدنا عمر، و منهم سبعمائة من قراء القرآن و ثار البراء بن مالك على مسيلمة و حزبه و جاء نصر اللّه فانهزموا و تبعهم المسلمون حتى أدخلوهم حديقة فأغلق أصحاب مسيلمة بابها فحمل البراء بن مالك درقته و ألقى نفسه عليهم حتى صار معهم في الحديقة و فتح الباب للمسلمين، فدخلوا و قتلوا مسيلمة و أصحابه، فسميت حديقة الموت، و كان الذي قتل مسيلمة و حشي كما في البخاري و هو القائل:
قتلت خير الناس و قتلت شر الناس، و يعني بخير الناس حمزة رضي الله عنه. و إلى ذلك أشار الشاطبي في العقيلة بقوله:
إن اليمامة أهواها مسيلمة ***الكذاب في زمن الصديق إذ خسرا
و بعد بأس شديد حان مصرعه ***و كان بأسا على القراء مستعرا
فلما رأى عمر رضي الله عنه ما وقع لقراء القرآن خشي على من بقي منهم و أن يذهب القرآن بذهابهم و أشار على أبي بكر بجمع القرآن.
أسند أبو عمرو في المحكم إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب
ص: 161
جاء إلى أبي بكر فقال: إن القتل قد أسرع في قراء القرآن أيام اليمامة و قد خشيت أن يهلك القرآن فاكتبه.
و في رواية أخرى: و قد خشيت أن يستحر- أي: يشتد- القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، و إني أرى أن تأمر بجمعه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، و لم يعهد إلينا فيه عهدا؟
فقال عمر رضي الله عنه: افعل فهو و اللّه خير، فلم يزل عمر بأبي بكر- رضي اللّه عنهما- حتى أرى اللّه- تعالى- أبا بكر مثل ما رأى عمر، و في رواية: قال أبو بكر: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح اللّه صدري لذلك، و رأيت في ذلك الذي رأى عمر.
قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: فدعاني أبو بكر و كان عنده عمر، فقال: إن هذا أتاني فقال: إن القتل قد استحر بالقراء و إني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في سائر المواطن فيذهب القرآن، و قد رأيت أن تجمعه فقلت لعمر:
كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول اللّه صلى الله عليه و سلم؟! فقال عمر: هو و اللّه خير و لم يزل يراجعني حتى شرح اللّه صدري و رأيت فيه الذي رأى و إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول اللّه صلى الله عليه و سلم فاجمعه و اكتبه، فقلت لهما: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول اللّه صلى الله عليه و سلم؟! فقالا: هو و اللّه خير، و لم يزالا يراجعاني في ذلك حتى شرح اللّه صدري للذي شرح له صدرهما و رأيت فيه الذي رأيا.
فإن قيل: كيف يقول عمر رضي الله عنه: خشيت أن يذهب القرآن مع علمه بقوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ قيل: معنى كلامه أن القرآن كان مكتوبا متفرقا فيذهب البعض بذهاب البعض فلا يعلم كيف كان وضع كتابته لا لفظه أو خاف أن ينقطع تواتره، أو أن الحفظ في الآية محمول على الحفظ من التحريف.
و إن قيل: كيف يقول أبو بكر رضي الله عنه: لم يأمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و سلم بكتابة
ص: 162
القرآن، مع ما في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، و من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه»، قيل: معنى كلامه: لم يأمرنا بجمع المتفرق في الرقاع و نحوها في صحيفة واحدة.
و إن قيل: كانت عدة كتاب رسول اللّه صلى الله عليه و سلم نحو الثلاثة و الأربعين صحابيا.
و من كتاب الوحي: أبو بكر الصديق، و عمر الفاروق، و عثمان بن عفان، و علي بن أبي طالب، و أبان بن سعيد، و خالد بن الوليد، و أبي بن كعب، و أرقم بن أبي الأرقم، و معاوية بن أبي سفيان، و ثابت بن قيس، و حنظلة بن الربيع، و أبو رافع القبطي، و خالد بن سعيد بن العاص، و زيد بن ثابت، و العلاء بن الحضرمي.
و من كتاب أموال الصدقة: الزبير بن العوام، و جهم بن الصلت.
و من كتاب خرص النخل: حذيفة بن اليمان.
و من كتاب المعاملات: المغيرة بن شعبة، و الحصين بن نمير رضي اللّه عنهم أجمعين.
و لما دخل المصريون على عثمان رضي الله عنه و ضرب أحدهم يمينه بالسيف و هو يقرأ الصحف رفع يده و قال: و اللّه إنها لأول كف خطت المفصل بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم.
و قال معاوية: قال لي رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: «يا معاوية، ألق الدواة و حرف القلم و انصب الباء و فرق السين و لا تغور الميم و حسن اللّه و مد الرحمن وجود الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أمكن لك»، و كان أكثرهم مداومة على ذلك بعد الهجرة زيد بن ثابت ثم معاوية بن أبي سفيان بعد فتح مكة.
و أول من كتب الوحي بها من قريش عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح لكنه ارتد و هرب من المدينة إلى مكة ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح.
ص: 163
و أول من كتبه بالمدينة أبي بن كعب رضي الله عنه، فلم خص أبو بكر زيدا بهذه الفضيلة؟ قيل: لكمال دينه و عدالته و حسن سيرته و علمه.
قال الحافظ أبو نعيم: خير الأمة علما و فقها و فرائض انتهى.
و قال الشعبي: وضع زيد بن ثابت رجله في الركاب ليركب فأمسكه له ابن عباس فقال له: تنح يا ابن عم رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، فقال: إنا هكذا نصنع بالعلماء فأخذ زيد يده فقبلها، و قال: هكذا أمرنا أن نفعل بأشرافنا و قال ابن عباس فيه إنه من الراسخين في العلم، و قال فيه حسان بن ثابت:
فمن للقوافي بعد حسان و ابنه و من للمثاني بعد زيد بن ثابت
و كان غاية في الذكاء و الفطنة، فعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللّه صلى الله عليه و سلم:
«إنه تأتيني كتب لا أحب أن يعلمها كل أحد فهل تستطيع أن تتعلم السريانية» فقلت: نعم. فتعلمتها في سبع عشرة ليلة. و لأنه جمع القرآن على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم.
و قرأ عليه بعد العرضتين الأخيرتين و كتب له الوحي، و إلى ذلك أشار الشاطبي في العقيلة بقوله:
نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا
فأجمعوا جمعة في الصحف و اعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظر
قال زيد: فو اللّه لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي منه.
و في رواية: لو كلفوني نقل الجبال لكان أيسر علي من الذي كلفوني، قال زيد: فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف و العسب و اللخاف و صدور الرجال.
و في رواية: فجعلت أتتبع القرآن من صدور الرجال و من الرقاع و من الأضلاع و من العسب، أي لأن القرآن كله كتب على عهده صلى الله عليه و سلم في هذه الأشياء لكن غير مجموع في موضع واحد و لا مرتب السور كما رواه أبو داود، قال زيد: ففقدت آية كنت أسمعها من رسول اللّه صلى الله عليه و سلم لم أجدها إلا
ص: 164
عند رجل من الأنصار و هي: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ (1) الآية فألحقتها.
و في رواية: فألقيتها في سورتها و قال: فذكرت آية، و في رواية: ثم فقدت آية أخرى، فاستعرضت المهاجرين و الأنصار أسألهم عنها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري و هي: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إلى آخر السورة فألحقتها بآخر براءة ثم عرضته على نفسي فلم أجد فيه شيئا، فإن قيل: قد كان زيد حافظ القرآن كاتب الوحي فما وجه تتبعه المذكورات و طلب شي ء يحفظه و يعلمه، و كيف يحصل التواتر بشي ء لم يجده إلا عند واحد؟ أجيب عن الأول بأنه رضي الله عنه كان يسأل غيره و يستكمل وجوه قراءته ممن عنده ما ليس عنده ليحيط بالسبعة التي نزل بها القرآن و كانت المكتوبات المتفرقة أو أكثرها مما كتب بين يديه صلى الله عليه و سلم و عرفت كتابتها و تيقن أمرها فلا بد من النظر فيها و إن كان حافظا ليستظهر بذلك و ليعلم هل فيها قراءة غير قراءته أم لا؟
و لأن الحافظ إذا استند عند الكتابة إلى أصل يعتمد كان آكد و أثبت؛ لأن وضع الخط على وفق الرسم المكتوب أبلغ في الصحة و الأصالة؛ و لأن العلم الحاصل من يقينين فأكثر أقوى مما يحصل بواحد.
و عن الثاني بأن معنى قوله: فقدت آية لم أرها مكتوبة، و قوله: لم أجدها إلا عند رجل. معناه: لم أجدها مكتوبة إلا عند رجل واحد أ لا تراه قال: عند. و لم يقل: في حفظ واحد، و التواتر لا يحصل بالكتابة و عدد القراء جاوز عدد التواتر فعلم مما ذكر أن زيدا رضي الله عنه كتب القرآن كله بجميع وجوه قراءته المعبر عنها في الحديث النبوي بالأحرف السبعة في صحف لأن تتبعه تلك الأشياء ظاهر في طلب الظفر بمتفقه و مختلفه، و لأن أبا بكر أمره بكتابة القرآن).
ص: 165
1- سورة الأحزاب الآية (23).
كله، و كل حرف من الحروف السبعة بعض من أبعاض القرآن فلو أخل ببعضها لم يكن كتب القرآن كله، و إلى ذلك أشار الشاطبي في العقيلة بقوله:
فقام فيه بعون اللّه يجمعه ***بالنصح و الجد و العزم الذي بهرا
من كل أوجهه حتى استتم له*** بالسبعة الأحرف العليا كما
ص: 166
الفصل الثاني في بيان من وضعت عنده الصحف التي جمع زيد فيها القرآن زمن أبي بكر رضي الله عنه و عن سبب جمع القرآن من تلك الصحف في المصاحف زمن عثمان رضي الله عنه و من جمعه
لما أتم زيد رضي الله عنه كتابة تلك الصحف على الوجه المطلوب حملها إلى أبي بكر فبقيت عنده مدة حياته، ثم لما حضرته الوفاة سلمها إلى عمر رضي الله عنه فأمسكها مدة حياته، فلما مات انتقلت إلى ابنته حفصة أم المؤمنين- رضي اللّه عنها- و أسلم أبو بكر الصحف إلى عمر لنصه على خلافته و لم يسلمها عمر إلى عثمان للشورى- رضي اللّه عنهم-، و هذا لا ينافي ما تقدم عن ابن حجر من أنها إنما كانت عند حفصة لأنها كانت وصية عمر إلى آخره، ثم لما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينية و أذربيجان و كان اتفق غزوهما في سنة واحدة و حضر غزو كل منهما جند الشام و جند العراق، و أرمينية- بفتح الهمزة عند السمعاني، و بكسرها عند غيره، و بسكون الراء و كسر الميم بعدها تحتية ساكنة فنون مكسورة فتحتية خفيفة و قد تثقل- مدينة عظيمة تشتمل على بلاد كثيرة و هي في جهة الشمال، يضرب بحسنها و طيب هوائها و كثرة مياهها و شجرها المثل.
و أذربيجان- بفتح الهمزة و الذال المعجمة و سكون الراء، و قيل: بسكون الذال و فتح الراء و كسر الموحدة بعدها تحتية ساكنة فجيم خفيفة و آخره نون- بلد كبير من نواحي جبل العراق يلي أرمينية من جهة غربيها، فرأى حذيفة ناسا من أهل دمشق يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم.
و رأى أهل الكوفة يقولون مثل ذلك و أنهم قرءوا على ابن مسعود، و أهل البصرة يقولون مثله و أنهم قرءوا على أبي موسى و يسمون مصحفه لباب
ص: 167
القلوب، فأفزعه ذلك و سار إلى عثمان بالمدينة فقال له: يا أمير المؤمنين، إني قد سمعت الناس اختلفوا في القرآن اختلاف اليهود و النصارى حتى أن الرجل ليقوم فيقول: هذه قراءة فلان، و في الوسيلة: أن الناس اختلفوا في القرآن حتى و اللّه إني أخشى أن يصيبهم ما أصاب اليهود و النصارى من الاختلاف فما كنت صانعا إذا قيل هذه قراءة فلان و قراءة فلان كما صنع أهل الكتاب فاصنعه الآن، فجمع عثمان رضي الله عنه الناس وعدتهم يومئذ اثنا عشر ألفا فقال:
ما ذا ترون؟ و في رواية: ما ذا تقولون؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، و هذا يكاد أن يكون كفرا، قالوا: فما ذا ترى؟ و في رواية كما في الدرة: قالوا: الرأي رأيك، قال: أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد فلا يكون اختلاف، فقالوا: نعم الرأي ما رأيت، فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف ننسخها ثم نردها إليك فأرسلت إليه بها.
قال الحافظ أبو الفضل القسطلاني: و كانت هذه القصة في سنة خمس و عشرين في السنة الثالثة أو الثانية من خلافه عثمان.
و قال الإمام ابن الجزري: كانت في حدود سنة ثلاثين من الهجرة فأحضر عثمان زيد بن ثابت و هو من الأنصار و نفرا من قريش، و هم: عبد اللّه ابن الزبير و عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن عمر بن الخطاب و عبد اللّه بن عمرو بن العاص و سعيد بن العاص و أبان بن سعيد و عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، فقال عثمان: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول اللّه صلى الله عليه و سلم زيد ابن ثابت، قال: فأي الناس أعرب؟- و في رواية: أفصح؟- قالوا: سعيد بن العاص، و قال: فليمل سعيد و ليكتب زيد، و قال لهم: انسخوا هذه الصحف في المصاحف و جعل الرئيس عليهم زيد بن ثابت، فجمعوا بين الدفتين المنزل من غير أن يكونوا زادوا أو نقصوا منه شيئا باتفاق منهم و من غير أن يقدموا شيئا أو يؤخروه و كتبوه في المصاحف على الترتيب المكتوب في اللوح المحفوظ
ص: 168
بتوقيف جبريل- عليه السلام- للنبي صلى الله عليه و سلم على ذلك، و إعلامه عند نزول كل آية بموضعها و أين تكتب، و لذا قال الإمام مالك رضي الله عنه: و إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه و سلم و كان زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة، و كان يقرئ الناس بها حتى مات، و لذلك اعتمده الصديق في جمعه و ولاه عثمان كتبة المصاحف انتهى.
و إنما أمر عثمان زيدا و من ضمهم إليه أن ينسخوا من الصحف مع أنهم كانوا حفظة لتكون مصاحف مستندة إلى أصل أبي بكر المستند إلى أصل النبي صلى الله عليه و سلم المكتوب بين يديه بأمره فيسد باب القالة و أن يزعم زاعم أن في الصحف قرآنا لم يكتب، و أن يرى إنسان فيما كتبوه شيئا مما لم يقرأ به فينكره فالصحف شاهدة بصحة جميع ما كتبوه، و خص زيدا فولاه كتبة المصاحف لأن أبا بكر و عمر- رضي اللّه عنهما- اختاراه و اعتمدا عليه في جمع المكتوبات المتفرقة في الصحف لما تقدم و ضم إليه جماعة مساعدة له و لينضم العدد إلى العدالة، و كانوا من قريش لأن القرآن نزل أول حروفه بلغتهم، و كانوا المعينين خاصة لاشتهار ضبطهم و معرفتهم فكتبوا من تلك الصحف المشتملة على الأحرف السبعة.
كما تقدم في عدة مصاحف القرآن كله مائة و أربع عشرة سورة، أولها الحمد للّه و آخرها الناس، و أول كل سورة منها بسم اللّه الرحمن الرحيم بقلم الوحي، إلا أول براءة فإنهم جعلوا مكانها بياضا و رتبوها على ما هي مرتبة في المصحف العثماني المنقول من صحف الصديق المنقولة بما كتب بين يدي رسول اللّه صلى الله عليه و سلم بأمره، و أخلوا المصاحف من أسماء السور و نسبتها و عددها و التجزئة و الفواصل اقتداء بأبي بكر، فإن صحفه عارية من ذلك، و جردوها أيضا مما ليس بقرآن فإن من الصحابة- رضي اللّه عنهم- من كانوا يكتبون في مصاحفهم التفسير الذي كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه و سلم.
ص: 169
قال المحقق ابن الجزري: كانوا- يعني الصحابة- ربما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا و بيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه و سلم قرآنا فهم آمنون من الالتباس، و ربما كان بعضهم يكتبه معه لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ذلك و يمنع منه، فروى مسروق عنه أنه كان يكره التفسير في القراءة.
و روى غيره: جردوا القرآن و لا تلبسوا به ما ليس منه. ا ه
ص: 170
الباب الثالث في الكلام على المصاحف العثمانية و فيه خمسة فصول
الفصل الأول في بيان ما اشتملت عليه المصاحف من القراءات
و مما لا نزاع فيه أن القرآن نسخ منه و غير فيه في العرضة الأخيرة فقد صح النص بذلك عن غير واحد من الصحابة.
قال الشمس بن الجزري في كتاب النشر: و روينا بإسناد عن زر بن حبيش: قال لي ابن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ قلت: الأخيرة، قال: فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعرض على جبريل- عليه السلام- القرآن يعني في كل عام مرة، قال: فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه و سلم مرتين، فشهد عبد اللّه- يعني ابن مسعود- ما نسخ منه و ما بدل فقراءة عبد اللّه الأخيرة. ا. ه فالصحابة- رضي اللّه عنهم- كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا أنه قرآن و ما علموه استقر في العرضة الأخيرة و ما تحققوا صحته عن النبي صلى الله عليه و سلم في غيرها مما لم ينسخ و لذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف و تركوا ما سوى ذلك نحو:
(فامضوا) و (كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا)، و (أما الغلام فكان كافرا) إلى غير ذلك، و إنما كتبوا مصاحف متعددة لأن عثمان رضي الله عنه قصد إنفاذ ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد المسلمين و استشهاره و من ثم بعث إلى أمرائه بها و كتبوها متفاوتة في إثبات و حذف و بدل و غيرها؛ لأنه رضي الله عنه قصد اشتمالها على الأحرف السبعة فجعلوا الكلمة التي تفهم أكثر من وجه بصورة واحدة نحو:
فَتَبَيَّنُوا و نُنْشِزُها و أُفٍّ و هَيْتَ و أَخَوَيْكُمْ على حالها في جميع المصاحف و التي لا تدل على أكثر من قراءة كذلك بصورة في البعض
ص: 171
و بأخرى في نحو:
(أوصى، و وصى) (سارعوا، و فسارعوا) (و بالزبر و بالكتاب، و الزبر و الكتاب) (خير منها، خيرا منها) (فتوكل، و توكل) (شركاؤهم، و شركائهم) (تجري تحتها، و تجري من تحتها) (أشد منكم، و أشد منهم) (بما كسبت، و فيما كسبت) (فإن اللّه هو الغني، و فإن اللّه الغني) إلى غير ذلك و إنما كتبت هذه في البعض بصورة و في آخر بأخرى لأنها لو كررت في مصحف لتوهم نزولها كذلك، و لو كتبت بصورة في الأصل بأخرى لأنها لو كررت في مصحف لتوهم نزولها كذلك، و لو كتبت بصورة في الأصل و بأخرى في الحاشية لكان تحكما مع إيهام التصحيح.
و جردها كلها أيضا من النقط المبين للحروف و الشكل الدال على الحركات، و لذلك كره ابن عمر و ابن مسعود- رضي اللّه عنهما- و جماعة من التابعين نقط المصحف و شكله كما ذكر في المقنع لما روي:
جردوا مصاحفكم، و إنما جردوها من النقط و الشكل لتحتمل الكلمة التي تفهم بصورة واحدة أكثر من وجه ما صح نقله و ثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجوه القراءات، إذ الاعتماد في نقل القرآن على الحفظ لا على مجرد الخط، فيقرأ نحو قوله تعالى: يَعْلَمُونَ بالغيب و الخطاب، و يُقْبَلُ بالتذكير و التأنيث، و نُنْشِزُها بالزاي و الراء، و فَتَبَيَّنُوا بمثناه فوقية فموحدة فمثناه تحتية فنون و بمثلثة بدل الموحدة فموحدة فمثناه فوقية، وَ لا تُسْئَلُ بالبناء للمفعول مع الرفع و بالبناء للفاعل مع الجزم، و أَخَوَيْكُمْ بالتثنية و الجمع إلى غير ذلك، و لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين، فإن الصحابة- رضي اللّه عنهم- تلقوا عن رسول اللّه صلى الله عليه و سلم ما أمره اللّه بتبليغه إليهم من القرآن لفظه و معناه جميعا، و لم يكونوا ليسقطوا شيئا من القرآن الثابت عنه صلى الله عليه و سلم، و لا ليمنعوا من القراءة به.
ص: 172
و قد أجمعت الصحابة- رضي اللّه عنهم- على هذه المصاحف و لم يختلف عليها اثنان حتى أن عليا رضي الله عنه قال: لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل.
و لما ولي الخلافة لم ينكر حرفا و لا غيره مع أنه هو الراوي: أن النبي صلى الله عليه و سلم يأمركم أن تقرءوا القرآن كما علمتم.
ص: 173
الفصل الثاني في بيان ما فعله عثمان بالمصاحف التي كتبت في زمنه و بالصحف التي كتبت في زمن أبي بكر الصديق- رضي اللّه عنهما-
و لما كان الاعتماد في نقل القرآن متفقا و مختلفا على الحفاظ أنفذهم إلى أقطار بلاد المسلمين للتعليم، و جعل هذه المصاحف أصولا ثواني حرصا على الإنفاذ، و لذلك أرسل إلى كل إقليم مصحفه مع من يوافق قراءته في الأكثر و ليس بلازم.
روي أن عثمان رضي الله عنه أمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدني، و بعث عبد اللّه ابن السائب مع المكي، و بعث المغيرة بن شهاب مع الشامي، و أبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، و عامر بن عبد قيس مع البصري، و كان في تلك البلاد في ذلك الوقت الجم الغفير من حفاظ القرآن التابعين فكان بالمدينة ابن المسيب و عروة و سالم و عمر بن عبد العزيز و سليمان و عطاء ابنا يسار و معاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القاري و عبد الرحمن بن هرمز و ابن شهاب الزهري و مسلم بن جندب و زيد بن أسلم.
و بمكة: عبيد اللّه بن عمير و عطاء و طاوس و مجاهد و عكرمة و ابن أبي مليكة.
و بالكوفة: علقمة و الأسود و مسروق و عبيدة و عمرو بن شرحبيل و الحارث بن قيس و الربيع بن خثيم و عمرو بن ميمون و أبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش و عبيد بن نضيلة و أبو زرعة بن عمرو و سعيد بن جبير و النخعي و الشعبي.
و بالبصرة: عامر بن قيس و أبو العالية و أبو رجاء و نصر بن عامر و يحيى ابن يعمر و جابر بن زيد و الحسن و ابن سيرين و قتادة.
و بالشام: المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان بن عفان في القراءة و خليد بن سعد صاحب أبي الدرداء و غيرهما، فقرأ أهل كل مصر بما
ص: 174
في مصحفهم و نقلوه عن الصحابة الذين تلقوه من في رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فقاموا في ذلك مقام الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم تجرد قوم للقراءة و الأخذ و اعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا في ذلك أئمة الاقتداء و أنجما للاهتداء يرحل إليهم و يؤخذ عنهم أجمع أهل بلدهم على تلقي قراءاتهم، و لم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم و لتصديهم للقراءة نسبت إليهم و كان المعول فيها عليهم، فقد أجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف و ترك ما خالفها من زيادة و نقص و إبدال كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة عليهم، و لم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن.
و أما الصحف الأولى التي كتبت منها المصاحف فعثمان رضي الله عنه لما فرغ من أمر المصاحف و نسخها طبق مراده و حرق ما سواها ورد تلك الصحف إلى حفصة- رضي اللّه عنها- فبقيت عندها إلى أن ولي مروان المدينة فطلبها منها ليحرقها فلم تجبه إلى ذلك فلما توفيت حضر جنازتها و طلب الصحف من أخيها عبد اللّه بن عمر فسيرها إليه عند انصرافه فحرقها خشية أن تظهر فيعود الناس إلى الاختلاف.
فإن قيل: الاختلاف باق إلى وقتنا هذا فما دعواكم الاتفاق؟
قيل: القراءات التي يعول عليها الآن لا تخرج عن المصاحف المذكورة فيما يرجع إلى زيادة أو نقصان أو بدل و كذا ما كان من الخلاف راجعا إلى شكل أو نقط لأن خطوط المصاحف كانت مهملة محتملة لجميع ذلك كما يقرأ فَصُرْهُنَّ بضم الصاد و كسرها.
و (كله) في إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ بالرفع و النصب و يَضُرُّكُمْ بضم الضاد و رفع الراء مشددة و بكسر الضاد و جزم الراء و لِيُقْضى بسكون القاف و ضاده معجمة مخففة و بضم القاف و صاد مهملة مشددة.
ص: 175
الفصل الثالث في بيان حكم تحريق المصحف
قال ابن شهاب: فردّ عثمان الصحف إلى حفصة و ألقى ما سوى ذلك من المصاحف. قاله في المقنع. ا ه و في اللبيب: أن عثمان رضي الله عنه ردّ الصحف إلى حفصة و أمرها أن تحرقها، و قيل: حرقها. ا ه، أي: مبالغة في إذهابها و سدّا لمادة الاختلاف.
و في الجعبري: و نزل تحريقه ما سواها على مصاحف الصحابة- رضي اللّه عنهم- لأنهم كانوا يكتبون فيها التفسير الذي يسمعونه من النبي صلى الله عليه و سلم، و يحتمل ذلك نحو الرقاع لئلا ينقلها من لا يعرف ترتيبها فيختل لها الصحف لاحتمال الرجوع إليها. ا ه بتصرف يسير فانظره مع قول اللبيب و أمرها الخ.
روي عن سويد بن علقمة قال: قال عليّ: لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان.
و عن مصعب بن سعد قال: أدركت الناس حين شقق عثمان رضي الله عنه المصاحف فأعجبهم ذلك و لم يعبه أحد. ا ه فكان ذلك دليلا على جواز إحراق الكتب صونا لها.
قال ابن بطال: و في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم اللّه في النار؛ لأن ذلك أكرم لها و حرز عن وطئها بالأقدام. ا ه و قال في الإتقان: إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى و نحوه فلا يجوز وضعه في شق و نحوه لأنه قد يسقط و يوطأ، و لا يجوز تمزيقه لما فيه من تقطيع الحروف و تفرقة الكلم، و في ذلك إزراء بالمكتوب كذا قال الحليمي.
قال: و له غسلها بالماء و إن حرقها بالنار فلا بأس، و قد حرق عثمان مصاحف كان فيها آية و قراءة منسوخة و لم ينكر عليه. ا ه و ذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل، لأن الغسالة قد تقع على الأرض و قد جزم القاضي حسين في تعليقه بحرمة التحريق؛ لأنه خلاف الاحترام، و النووي بالكراهة. فالمسألة خلافية. و اللّه أعلم.
ص: 176
الفصل الرابع في بيان عدد المصاحف العثمانية
و اختلف في عدد المصاحف التي كتبها عثمان فقيل- و هو الذي صوبه ابن عاشر في شرح الإعلان- أنها ستة: المكي و الشامي و البصري و الكوفي و المدني العام الذي سيره عثمان رضي الله عنه من محل نسخه إلى مقره، و المدني و الخاص به الذي حبسه لنفسه و هو المسمى بالإمام.
و قال الحافظ ابن حجر و الجلال السيوطي- رحمهما اللّه-: المشهور أنها خمسة، و قال صاحب زاد القرّاء: لما جمع عثمان القرآن في مصحف سماه الإمام و نسخ منه مصاحف فأنفذ منها مصحفا إلى مكة، و مصحفا إلى الكوفة، و مصحفا إلى البصرة، و مصحفا إلى الشام، و حبس مصحفا بالمدينة.
و قال الجعبري: حبس مصحفا بالمدينة للناس، و آخر لنفسه و سيّر باقيها إلى أمرائه ... ثم قال: و مجموعها ثمانية: خمسة متفق عليها، و ثلاثة مختلف فيها. ا ه يعني بالخمسة المتفق عليها: الكوفي، و البصري، و الشامي، و المدني العام، و المدني الخاص، و بالثلاثة المختلف فيها: المكي، و مصحف البحرين، و مصحف اليمن، لقول العلامة الشاطبي- رحمه اللّه-:
و سار نسخ منها مع المدني كوف و شام و بصر تملأ البصرا
و قيل مكة و البحرين مع يمن صاعت بها نسخ في نشرها
فإن قلت: ما ذكره الشاطبي في البيتين سبعة لا ثمانية، قلت: بل ثمانية؛ فإن المدني يشمل العام و الخاص، بدليل قوله في سورة البقرة: أوصى الإمام مع الشامي و المدني، فإنه صريح في تعدد المدني.
و ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن في مصحف سماه الإمام نسخ منه مصاحف فحبس لنفسه الإمام و سير المدني إلى مقره و سير باقيها إلى أمراء الأمصار و قيل إن مصر سيّر إليها مصحف.
ص: 177
الفصل الخامس في بيان الفرق بين المصاحف و الصحف و بين جمع أبي بكر و جمع عثمان- رضي اللّه عنهما-
و الفرق بين الصحف و المصاحف: أن الصحف هي الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر، و كان سورا مفرقة، كل سورة مرتبة بآياتها على حدة لكن لم يرتب بعضها إثر بعض فلما نسخت و رتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا.
و الفرق بين جمع أبي بكر و جمع عثمان: أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شي ء بذهاب حملته، فجمعه في صحائف مرتبة الآيات النبوية على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه و سلم. و جمع عثمان كان لما كثر الخلاف في وجوه القراءات حتى قرءوه بلغاتهم على اتساع اللغات حتى أدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره، فترتيب الآي في الصحف، و ترتيبها و ترتيب السور في المصحف هو ترتيب النبي صلى الله عليه و سلم.
قال الحافظ أبو عمرو الداني في العدد: و عنه أخذوا رأس آية آية و كذلك القول عندنا في تأليف السور و تسميتها و ترتيبها في الكتابة. ا ه و قد أخرج أصحاب السنن الثلاث و صححه الحاكم و غيره من حديث ابن عباس عن عثمان- رضي اللّه عنهم- قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و سلم تنزل عليه الآيات فيقول: «ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا». ا ه و إلى ما ذكر أشار الشاطبي في العقيلة بقوله:
فأمسك الصحف الصديق ثم إلى ***الفاروق أسلمها لما قضى العمرا
و عند حفصة كانت بعد فاختلف*** القراء فاعتزلوا في أحرف زمرا
ص: 178
و كان في بعض مغزاهم مشاهدهم ***حذيفة فرأى في خلفهم عبرا
فجاء عثمان مذعورا فقال له ***أخاف أن يخلطوا فادرك البشرا
فاستحضر الصحف الألى التي ***و خص زيدا و من قريشه نفرا
على لسان قريش فاكتبوه كما ***على الرسول به أنزل انتشرا
فجردوه كما يهوى كتابته*** ما فيه شكل و لا نقط فيحتجرا
و فيما ذكر الدليل القاطع على اشتمال المصاحف العثمانية على جميع القراءات التي يقرأ بها الآن.
ص: 179
الباب الرابع في الكلام على ما يجوز من القراءات و ما لا يجوز، و فيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في بيان ضابط ما يسمى قرآنا
اعلم أن الضابط الصحيح للقراءات، و الحد الجامع لما يقرأ به من الروايات، هو كل ما وافق أحد المصاحف العثمانية و لو تقديرا، و وافق العربية و لو بوجه، و صح إسنادا، سواء أ كان عن القراء السبعة أم العشرة أم غيرهم، و متى اختل ركن من هذه الثلاثة في حرف يحكم عليه بالشذوذ، و قال المحقق ابن الجزري في الطيبة:
فكل ما وافق وجه نحوي و كان للرسم احتمالا يحوي
و صح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان
و حيثما يختل ركن اثبت شذوذه لو أنه في السبعة
و قال في النشر: كل قراءة وافقت العربية و لو بوجه، و وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا و صح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها و لا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن و وجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين.
و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء أ كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو و عثمان بن سعيد الداني، و نص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، و كذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدي و حققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، و هو مذهب
ص: 180
السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.
قال أبو شامة- رحمه اللّه- في كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة و يطلق عليها لفظ الصحة و أنها كذلك أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط.
و حينئذ فلا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره و لا يختص ذلك بنقلها عنهم.
بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة و غيرهم منقسمة إلى المجمع عليه و الشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم.
قلت: و قولنا في الضابط و لو بوجه تريد به وجهان من وجوه النحو سواء أ كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع و ذاع.
و تلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم و الركن الأقوم.
و هذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم و لم يعتبر إنكارهم.
بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان (بارئكم) و (يأمركم) و نحوه و (سبأ) و (يا بني) و (مكر السيئ) و (ننجي المؤمنين) في الأنبياء و الجمع بين الساكنين في تاءات البزي و إدغام أبي عمرو و (اسطاعوا) لحمزة و إسكان (نعما) و (يهدي) و إثبات الياء في (نرتعي) و (يتقي و يصبر) و (أفئدة من الناس) و ضم (الملائكة اسجدوا) و نصب (كن فيكون) و خفض (و الأرحام) و نصب (ليجزي قوما) و الفصل بين المضافين في الأنعام و همز (ساقيها) و وصل (و إن إلياس) و ألف (إن هذان) و تخفيف (و لا تتبعان) و قراءة (ليكة) في الشعراء و ص و غير ذلك.
ص: 181
قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه الجامع «جامع البيان» بعد ذكره إسكان (بارئكم، و يأمركم) لأبي عمرو، و حكاية إنكار سيبويه له فقال- أعني الداني-: و الإسكان أصح في النقل و أكثر في الأداء و هو الذي أختاره و آخذ به،- ثم لما ذكر نصوص رواته- قال: و أئمة القراء لا نعتمد في شي ء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة و الأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر، و الأصح في النقل و الرواية إذا ثبتت عنهم لا يردها قياس عربية و لا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها و المصير إليها.
قلت: و نعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر: (قالوا اتخذ اللّه ولدا) في البقرة بغير واو، و (بالزبر و بالكتاب المنير) بزيادة الباء في الاسمين و نحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي و كقراءة ابن كثير: (جنات تجري من تحتها الأنهار) في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة (من) ... فإذا ذلك ثابت في المصحف المكي، و كذلك (فإن اللّه الغني) في سورة الحديد بحذف (هو) و كذا (سارعوا) بحذف الواو، و كذا (منهما منقلبا) بالتثنية في الكهف ... إلى غير ذلك في مواضع مصحفهم، فلو لم يكن ذلك كذلك في شي ء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه.
و قولنا بعد ذلك: و لو احتمالا نعني به ما يوافق الرسم و لو تقديرا إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا و هي الموافقة الصريحة و قد تكون تقديرا و هي الموافقة احتمالا، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا: (السموت و الصلحت و أولئك و الصلوة و الزكوة و الربوا) و نحو: لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ و جي ء في الموضعين. حيث كتب بنون واحدة و بألف بعد الجيم في بعض المصاحف.
و قد يوافق بعض القراءات الرسم تحقيقا و يوافق بعضها تقديرا نحو:
(ملك يوم الدين) فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف، فقراءة الحذف
ص: 182
تحتمله تحقيقا كما كتب مَلِكِ النَّاسِ و قراءة الألف تحتمله تقديرا كما كتب مالِكَ الْمُلْكِ، فتكون الألف حذفت اختصارا.
و كذلك النَّشْأَةَ حيث كتبت بالألف وافقت قراءة المد تحقيقا و وافقت قراءة القصر تقديرا إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة على غير قياس، كما كتب مَوْئِلًا و قد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا نحو:
أَنْصارُ اللَّهِ و فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ و نَغْفِرْ لَكُمْ و يَعْمَلُونَ و هَيْتَ لَكَ، و نحو ذلك مما يدل تجرده عن النقط و الشكل و حذفه و إثباته على فضل عظيم للصحابة- رضي اللّه عنهم- في علم الهجاء خاصة، و فهم ثاقب في تحقيق كل علم، فسبحان من أعطاهم و فضلهم على سائر هذه الأمة!!! ... إلى أن قال:
قلت: فانظر كيف كتبوا (الصراط) و (المصيطرون) بالصاد المبدلة من السين و عدلوا عن السين التي هي الأصل فيعتدلان، و تكون قراءة الإشمام محتملة، و لو كتب ذلك على الأصل لفات ذلك و عدت قراءة غير السين مخالفة للرسم و الأصل.
و لذلك كان الخلاف في المشهور في (بصطة) الأعراف دون (بسطة) البقرة؛ لكون حرف البقرة كتب بالسين و حرف الأعراف بالصاد، على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا إذا ثبت القراءة به و وردت مشهورة مستفيضة، أ لا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد، و حذف ياء (تسألني) في الكهف، و قراءة (و أكون من الصالحين) و الظاء من (بظنين) و نحو ذلك من مخالفة الرسم المردودة، فإن الخلاف في ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد، و تمشية صحة القراءة و شهرتها و تلقيها بالقبول، و ذلك بخلاف زيادة كلمة و نقصانها و تقديمها و تأخيرها حتى و لو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني فإن حكمه حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه.
و هذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم و مخالفته.
ص: 183
الفصل الثاني هل يكفي في ثبوت القراءة صحة السند أو لا بد من التواتر؟
قال العلامة ابن الجزري: و قولنا: و صح سندها، نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم.
و قد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن و لم يكتف فيه بصحة السند و زعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر.
و أن ما جاء مجي ء الآحاد لا يثبت به قرآن، و هذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من موافقة الرسم و غيره إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه و سلم وجب قبوله و قطع بكونه قرآنا سواء أ وافق الرسم أم خالفه، و قال الإمام أبو محمد مكي في مصنفه الذي ألحقه بكتاب الكشف له، فإن سأل سائل فقال: ما الذي يقبل من القراءات الآن فيقرأ به و ما الذي يقبل و لا يقرأ به و ما الذي لا يقبل فلا يقرأ به؟ فالجواب: أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم و ذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، و هن: أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه و سلم، و يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا، و يكون موافقا لخط المصحف.
فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به و قطع على تعيينه و صحته و صدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف و كفر من جحده، قال: و القسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد و صح وجهه في العربية و خالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل و لا يقرأ به لعلتين:
إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد، و لا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.
ص: 184
و العلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على تعيينه و صحته و ما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به و لا يكفر من جحده، و لبئس ما صنع إذ جحده.
قال: و القسم الثالث هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة و لا وجه له في العربية، فهذا لا يقبل و إن وافق خط المصحف.
قال: و لكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارا، قال الشمس بن الجزري: و مثال القسم الأول: (مالك و ملك) (و يخدعون و يخادعون)، (و أوصى و وصى) (و يطوع و تطوع) ... و نحو ذلك من القراءات المشهورة.
و مثال القسم الثاني: قراءة عبد اللّه بن مسعود و أبي الدرداء: (و الذكر و الأنثى) و قراءة ابن عباس: (و كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا)، (و أما الغلام فكان كافرا) ... و نحو ذلك مما ثبت برواية الثقات إلى أن قال:
و مثال القسم الثالث: مما نقله غير ثقة كثير كما في كتب الشواذ مما غاب إسناده ضعيف كقراءة ابن السميفع و أبي السمال و غيرهما في: (ننحيك ببدنك) بالحاء المهملة و (لمن أخلفك آية) بفتح اللام، و كالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي و نقلها عنه أبو القاسم الهذلي و غيره و منها: إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ برفع الهاء و نصب الهمزة، و قد راج ذلك على أكثر المفسرين و نسبها إليه و تكلف توجيهها فإنها لا أصل لها و إن أبا حنيفة لبري ء منها.
و مثال ما نقله ثقة و لا وجه له في العربية و لا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو و الغلط و عدم الضبط يعرفه الأئمة المحققون و الحفاظ الضابطون و هو قليل جدّا بل لا يكاد يوجد و قد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع: (معايش) بالهمز.
ص: 185
و ما رواه ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء أَدْرِي أَ قَرِيبٌ مع إثبات الهمزة و هي رواية زيد و أبي حاتم عن يعقوب.
و ما رواه أبو علي العطار عن العباس عن أبي عمرو و (ساحران تظاهرا) بتشديد الظاء و النظر في ذلك لا يخفى، و يدخل في هذين القسمين ما يذكره بعض المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف حمزة نحو: بِأَسْمائِهِمْ و أُولئِكَ بياء خالصة، و نحو: شُرَكاؤُكُمُ و أَحِبَّاؤُهُ بواو خالصة و نحو: بَدَأَكُمْ و أَخاهُ بألف خاصة و نحو:
(رأى، و تراءى، ترى، و اشمئزت، و اشمزت، و فادّراتم، فادّرأتم) بحذف الهمزة في ذلك كله مما يسمونه التخفيف الرسمي، و لا يجوز في وجه من وجوه العربية، فإنه إما أن يكون منقولا عن ثقة و لا سبيل إلى ذلك فهو مما لا يقبل إذ لا وجه له، و إما أن يكون منقولا عن غير ثقة فمنعه أحرى، و ردّه أولى، مع أني تتبعت ذلك فلم أجده منصوصا لحمزة لا بطريق صحيحة و لا ضعيفة ... ثم قال: و بقي قسم مردود أيضا و هو ما وافق العربية و الرسم و لم ينقل البتة، فهذا رده أحق و منعه أشد و مرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر.
و قد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي و كان بعد الثلاثمائة، قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: و قد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة و غيرها فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل. قلت: و قد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء و القراء و أجمعوا على منعه، و أوقف للضرب فتاب و رجع و كتب عليه بذلك محضر كما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد، و أشرنا إليه في الطبقات انتهى.
ص: 186
الفصل الثالث في بيان حكم القراءة بالقياس و حكم التلفيق في القراءة و تقسيم القراءات إلى ستة أنواع
قال ابن الجزري. و من ثم:- يعني و من أجل أنه لا تجوز القراءة بما وافق العربية و الرسم العثماني و لم ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه و سلم- امتنعت القراءة بالقياس المطلق و هو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه و لا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه، كما روينا عن عمر بن الخطاب و زيد بن ثابت- رضي اللّه عنهما- من الصحابة، و عن ابن المنكدر و عروة بن الزبير و عمر بن عبد العزيز و عامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول فاقرءوا كما علمتموه، و لذلك كان كثير من أئمة القراء كنافع و أبي عمرو يقول: لو لا ليس لي أن أقرأ إلا بما أقرئت لقرأت حرف كذا كذا و حرف كذا كذا، أما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو على أصل يعتمد فيه فيصار إليه عند عدم النص و غموض وجه الأداء فإنه مما يسوغ قبوله و لا ينبغي ردّه لا سيما فيما تدعو الضرورة و تمس الحاجة مما يقوّي وجه الترجيح و يعين على قوة التصحيح بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء، و في إثبات البسملة و عدمها لبعض القراء و نقل:
(كتابيه إني) و إدغام: (ماليه هلك) قياسا عليه و نحو ذلك مما لا يخالف نصّا و لا يرد إجماعا و لا أصلا مع أنه قليل جدّا. انتهى بتصرف.
و إلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب- رحمه اللّه- في آخر كتابه التبصرة حيث قال: فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قرأت به و نقلته و هو منصوص في الكتب موجود، و قسم قرأت به و أخذته لفظا أو سماعا و هو غير موجود في الكتب، و قسم لم أقرأ به و لا وجدته في الكتب و لكن قسته على ما قرأت به، إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم
ص: 187
الرواية في النقل و النص و هو الأقل.
قال المحقق ابن الجزري: و قد زل بسبب ذلك قوم و أطلقوا قياس ما لا يروى على ما يروى، و ما له وجه ضعيف على الوجه القوي كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة عن النون و التنوين، و قطع بعض القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسر و الياء و إجازة بعض من بلغنا عنه ترقيق لام الجلالة تبعا لترقيق الراء من ذكر اللّه إلى غير ذلك مما تجده في موضعه ظاهرا في التوضيح مبينا بالتصحيح مما سلكنا فيه طريق السلف و لم نعدل فيه إلى تمويه الخلف، و لذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض و خطئ القارئ بها في السنة و الفرض.
قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد السخاوي في كتابه جمال القرّاء، و خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. ا ه.
و قال السيوطي في الإتقان: الذي تحرر لي أن القراءات أنواع:
الأول: المتواتر، و هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم.
مثاله: ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة و هذا هو الغالب في القراءات.
الثاني: المشهور، و هو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله، و وافق العربية، و وافق أحد المصاحف العثمانية سواء أ كان عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين و اشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط و لا من الشذوذ إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر.
مثاله: ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض.
و من أشهر ما صنف في هذين النوعين: «التيسير» للداني و «الشاطبية» و «طيبة النشر في القراءات العشر».
ص: 188
الثالث: الآحاد، و هو ما صح سنده و خالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور فلا يقرأ به.
من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ: «متكئين على رفارف خضر و عباقري حسان»، و منه قراءة: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بفتح الفاء.
الرابع: الشاذ و هو ما لم يصح سنده كقراءة ابن السميفع: «فاليوم ننحيك ببدنك» بالحاء المهملة، «لتكون لمن خلفك آية» بفتح اللام.
الخامس: الموضوع كقراءة الخزاعي السابقة.
السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، و هو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص: «و له أخ أو أخت من أم»، و قراءة ابن عباس: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج»، و قراءة الزبير: «و لتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يستعينون باللّه على ما أصابهم» و إنما كان شبيها و لم يكن مدرجا حقيقة لأنه وقع فيه خلاف، قال عمر رضي الله عنه: فما أدري أ كانت قراءته- يعني الزبير- أم فسرن. أخرجه سعيد بن منصور، و أخرجه ابن الأنباري و جزم بأنه تفسير، و كان الحسن يقرأ: «و إن منكم إلا واردها» الورود الدخول، قال ابن الأنباري: قوله: الورود الدخول تفسير من الحسن لمعنى الورود، و غلط فيه بعض الرواة فأدخله في القرآن.
قال ابن الجزري في آخر كلامه: و ربما كانوا يدخلون التفسير في القرآن إيضاحا؛ لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه و سلم قرآنا فهم آمنون من الالتباس انتهى بتصرف.
ص: 189
الباب الخامس في الكلام على حكم اتباع رسم المصاحف العثمانية و فيه فصول و ثلاثة تنبيهات و تتمة و فائدة مهمة
اشارة
و إذ قد ثبت أن القرآن كله كان مكتوبا في عهده صلى الله عليه و سلم لكن غير مجموع في موضع واحد و لا مرتب السور، و أنه صلى الله عليه و سلم ترك جمعه في مصحف واحد لأن النسخ كان يرد على بعضه فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه لأدى ذلك إلى الاختلاف فحفظه اللّه في الصدور إلى انقضاء زمن النسخ.
و أنه جمع في المصحف لاقتضاء المصلحة ذلك في زمن الصديق و نسخ كذلك من تلك الصحف في المصاحف في زمن عثمان و أن الصحابة رضي اللّه عنهم أجمعين جمعوا بين الدفتين القرآن المنزل من غير أن يكونوا زادوا فيه أو أنقصوا منه شيئا أو قدموا شيئا أو أخروه.
بل كتبوه في المصاحف على الترتيب المكتوب في اللوح المحفوظ بتوقيف جبريل- عليه السلام- للنبي صلى الله عليه و سلم على ذلك و إعلامه عند نزول كل آية بموضعها و أين تكتب، و أنهم- رضي اللّه عنهم- قد أجمعوا على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر و عمر و إرسال كل مصحف منها إلى مصر من أمصار المسلمين، و أجمعوا على ترك ما سوى ذلك، و أن أهل كل مصر أجمعوا على تلقي ما في مصحفهم بالقبول.
و هذا إجماع من الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف و على ترك ما خالفها من زيادة و نقص و إبدال كلمة بأخرى و حرف بآخر وجب علينا أن نتبع في قراءتنا المرسوم الذي جعله لنا عثمان رضي الله عنه في المصحف أصلا.
و لذا قال الأئمة المحققون: كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل و مجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي المعتبرة، و أن نقتدي في كتبنا القرآن بكتبه لجعل المصحف إماما متبعا لكل من يكتب القرآن فلا يجوز لمن يكتب مصحفا أن يكتبه على خلاف الرسم العثماني.
ص: 190
فصل في ذكر أدلة وجوب اتباع رسم المصحف العثماني
قال العلامة الخراز في موارد الظمآن:
و بعد فاعلم أن أصل الرسم*** ثبت عن ذوي النهى و العلم
جمعه في الصحف الصديق ***كما أشار عمر الفاروق
و ذاك حين قتلوا مسيلمة ***و انقلبت جيوشه منهزمة
و بعده جرده الإمام ***في مصحف ليقتدي الأنام
و لا يكون بعده اضطراب ***و كان فيما قد رأى صواب
فقصة اختلافهم شهيرة ***كقصة اليمامة العسيرة
فينبغي لأجل ذا أن نقتفي ***مرسوم ما أصله في المصحف
و نقتدي بفعله و ما رأى ***في جعله لمن يخلط ملجا
قال الأستاذ ابن عاشر في شرح قوله: فينبغي ... الخ. أي: يطلب منا أن نتبع في قراءاتنا المرسوم الذي جعله لنا في المصحف أصلا، و أن نقتدي في كتبنا القرآن بكتبه رضي الله عنه و برأيه في جعل المصحف ملجأ، أي: مفزعا و حصنا و إماما متبعا لمن يكتب ... إلى أن قال: فلما كتب المصاحف أمر الناس بالاقتصار على ما وافقها لفظا و بمتابعتها خطّا و لذلك أمر بما سواها أن يحرق إذ لو لا قصده جعل هذه المصاحف أئمة للقارئين و الكاتبين ما أمر بتحريق ما سواها و هذا معنى قوله في عميد البيان:
فواجب على ذوي الأذهان ***أن يتبعوا المرسوم في القرآن
و يقتدوا بما رآه نظرا ***إذ جعلوه للأنام وزرا
و كيف لا يجب الاقتدا ***لما أتى نصابه الشفا
إلى عياض أنه من غيرا ***حرفا من القرآن عمدا كفرا
زيادة أو نقصا أو إن بدلا ***شيئا من الرسم الذي تأصلا
ص: 191
ثم قال: و الظاهر أو المتعين أن مراد عياض بالنقص إنما هو النقص اللفظي لا الخطي، و كذا التبديل و الزيادة خلاف ما يقتضيه نقل الخراز عنه أن المراد النقص في الخط و التبديل و الزيادة فيه، إلا أن يتأول قوله من الرسم الذي تأصلا بأن المعنى: أن من غير حرفا لفظا بنقص أو تبديل أو زيادة من القرآن المدلول عليه برسم المصحف فهو كافر، و حينئذ فلا يكون مقصود الناظم بما نقل عن عياض إفادة كفر من تعمد نقص حرف من رسم المصحف أو تبديلا أو زيادة فيه، و إنما قصدنا تأكد الوجوب في ترك هذه المخالفات الخطية.
ثم قال: و هاهنا بحث و هو أنه قد روي عن بعض الصحابة واحد أو اثنين أنه خالف الإمام في تحريق ما بأيديهم و تركه و متابعة المصاحف العثمانية و كيف يتقرر الإجماع مع مخالفة بعض المجتهدين.
و الجواب: أن الإجماع إذا اختلف هل يقدح في مخالفته الواحد و الاثنان أم لا؟
و الأول مذهب الجمهور فعليه يجاب بأن الإجماع انعقد بعد موت المختلف، و أما القول الثاني فلا يرد عليه إشكال. ا ه و قد وردت أحاديث في طلب الاقتداء بالصحابة- رضي اللّه عنهم-، منها ما ورد في أبي بكر و عمر- رضي اللّه عنهما-، و هو ما أخرجه الإمام أحمد و الترمذي و ابن ماجة من قوله صلى الله عليه و سلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر».
زاد الطبراني عن أبي الدرداء: «فإنهما حبل اللّه الممدود من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى».
و قال صلى الله عليه و سلم: «إن اللّه يكره أن يخطئ أبو بكر»، و قال صلى الله عليه و سلم: «إن اللّه لينطق بالحق على لسان عمر».
و روى أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و ابن حبان، قال الحافظ المنذري:
و هو حديث حسن صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول
ص: 192
اللّه صلى الله عليه و سلم موعظة وجلت منها القلوب و ذرفت العيون فقلنا: يا رسول اللّه كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه و العمل و السمع و الطاعة و إن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، و إياكم و محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار».
و قد حث الإمام مالك رضي الله عنه على اتباع الصحابة- رضي اللّه عنهم- و ترك مخالفتهم فيما فعلوه من الرسم، لأنه منع السائل و هو الإمام أشهب من أن يحدث في مصاحفهم النقط الذي حدث بعدهم لأنهم كتبوها من غير نقط و شكل. و إنما رأى النقط جائزا للصبيان، أي: و من في معناهم من كبار المتعلمين في الصحف و الألواح لأجل بيانه- أي: وضوحه و سهولة تعلمه عليهم-. قال أبو عمرو في المحكم بسنده إلى عبد اللّه بن عبد الحكم: قال أشهب: سئل مالك- رحمه اللّه- فقيل له: أ رأيت من استكتب مصحفا اليوم أ ترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك و لكن يكتب على الكتبة الأولى، و إلى ذلك أشار الشاطبي في العقيلة بقوله:
و قال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا
قال أبو عمرو في المقنع: و لا مخالف له في ذلك من علماء الأمة، و ذكر مثله الجعبري في شرح العقيلة.
ثم قال أيضا: و هذا مذهب الأئمة الأربعة- رضوان اللّه عليهم- و خص مالكا لأنه حكى فتياه و مستندهم مستند الخلفاء الأربعة- رضي اللّه عنهم- أجمعين، و معنى قول مالك: يكتب على الكتبة الأولى: تجريده من النقط و الشكل و وضعه على مصطلح الرسم من البدل و الحذف و الإثبات و الفصل و الوصل. ا ه بتصرف.
و في الإتقان: قال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو
ص: 193
أو ألف أو ياء و غير ذلك. ا ه و سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن زائدة مثل الواو و الألف و الياء في مثله قوله تعالى: «الربوا، و أولئك، و لأذبحنه، و بأييد، و بأييكم» و ما أشبه ذلك.
ترى أن تغير من المصاحف إذا وجدت فيها كذلك؟ قال: لا. ا ه فما كتبوه في المصاحف بغير ألف فواجب أن يكتب بغير ألف، و ما كتبوه بألف كذلك و ما كتبوه متصلا فواجب أن يكتب متصلا، و ما كتبوه منفصلا فواجب أن يكتب منفصلا و ما كتبوه بالتاء فواجب أن يكتب بالتاء، و ما كتبوه بالهاء فواجب أن يكتب بالهاء. فلا يثبت ما حذف و لا يحذف ما أثبت لإجماع الأمة على متابعتها فمن خالف في شي ء من ذلك فقد خالف الأمة كما قاله ابن الحاج في المدخل، و الحافظ أبو عمرو الداني و اللبيب، قال أشهب: قال مالك: و لا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن فأقول له أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقط، و لا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها.
و أما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان و ألواحهم فلا أرى بذلك بأسا. قال عبد اللّه: و سمعت مالكا لما سئل عن شكل المصاحف، قال:
أما الأمهات فلا أراه، و أما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان فلا بأس. ا ه و المراد بالأمهات في كلام الإمام المصاحف الكمل و بالمصاحف الصغار الصحف، قال الخراز في مورد الظمآن:
و مالك حض على الاتباع ***لفعلهم و ترك الابتداع
و إذ منع السائل من أن يحدثا ***في الأمهات نقط ما قد أحدثا
و إنما رآه للصبيان*** في الصحف و الألواح للبيان
و الأمهات ملجأ للناس ***فمنع النقط للالتباس
ص: 194
قال شارحه العلامة ابن عاشر: أخبر هنا أن إمام المذهب المدني مالكا رضي الله عنه حث على اتباع الصحابة في المصاحف و ترك الابتداع المحدث فيها، و لا شك أن هذا المعنى المقصود للناظم هنا لم يقع في كلام مالك صريحا، و إنما هو لازم منعه السائل من أن يحدث في المصاحف الأمهات- أي: الكمل- النقط المحدث، و إنما رأى الإمام جواز النقط للصبيان يريد و من في معناهم من كبار المتعلمين في الصحف يعني الصغار و في الألواح للإيضاح. ا ه
ص: 195
تنبيهات:
الأول في ذكر بعض فوائد الرسم العثماني و بعض مضار مخالفته
قد علمت مما تقدم آنفا أنه يجب كتب القرآن موافقا لرسم المصاحف العثمانية، و يحرم تغيير حرف منه عما كتب عليه في زمن الصحابة الذين تلقوه من في رسول اللّه صلى الله عليه و سلم و كتبوه في حضرته و أجمعوا على نقله و نشره في بلاد المسلمين، و عدتهم يومئذ- رضي اللّه عنهم- فوق اثني عشر ألفا، و بعدهم أجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب اتباعه.
و لنذكر هنا شيئا من فوائد هذا الرسم المخصوص و شيئا من مضار مخالفته تأكيدا لما تقدم فنقول:
من فوائده: أنه حجاب مانع من تلاوة القرآن على وجهه بدون موقف لأن الشأن التحفظ على النفيس، و لذا لا يجوز لأحد أن يقرأ أو يقرئ إلا بما رواه عن شيخ متصل السند بل، لو قرأ بمضمن كتاب من غير رواية و مشافهة لا يعد مقرئا.
قال ابن الجزري في المنجد- بعد أن ذكر أن القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن و اختلافها معزوا لناقله- ما نصه: و المقرئ العالم بها مؤديا لها مشافهة فلو حفظ التيسير مثلا ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه في شوفه مسلسلا، لأن في القرآن أشياء لا تحكم إلا بالسماع و المشافهة. ا ه و قال أيضا في تقسيم المقرئين: و منهم من علم العربية و لا يتبع الأثر و المشايخ في القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. ا ه و منها: الدلالة على أصل الحركة ككتابة الكسرة ياء، و الضمة واوا في نحو: «إيتائ ذي القربى، و سأوريكم» أو الحرف ككتابة: «الصلاة و الزكاة و الحياة» بالواو.
و منها: النص على بعض اللغات الفصيحة ككتابة هاء التأنيث بالتاء على لغة طيئ، و كحذف آخر المضارع المعتل اللام لغير جازم نحو حذف الياء
ص: 196
من: (يوم يأت لا تكلم نفس) على لغة هذيل.
و منها: عدم تجهيل الناس بأوليهم و كيفية ابتداء كتابتهم.
و من المضار التي تترتب على مخالفته: ضياع القرآن الذي هو أساس الدين بضياع شرطه.
و منها: ضياع لغات العرب الفصحى لعدم الاستدلال عليها من أصدق الحديث بضياع رسمه الدال عليها.
و منها: تطرق التحريف إلى الكتاب الشريف بتغير رسمه الأصلي التوقيفي.
و منها: جواز هدم كيان كثير من العلوم قياسا على هدم كيان علم رسم القرآن بدعوى سهولة تناوله للعلوم.
ص: 197
الثاني في بيان أن رسم القرآن توقيفي
ذكر العلامة أحمد بن المبارك في كتاب الذهب الإبريز عن شيخه العارف باللّه تعالى الشيخ عبد العزيز الدباغ أنه قال: رسم القرآن سر من أسرار اللّه المشاهدة، و كمال الرفعة، فقلت له: هل رسم الواو بدل الألف في نحو قوله: «الصلاة، و الزكوة، و الربوا، و الحيوة، و مشكوة»، و زيادة الواو في:
«سأوريكم، و أولئك، و أولاء، و أولات»، و كالياء في نحو: «هديهم، و ملائيه، و بأييكم، و بأييد».
هذا كله صادر من النبي صلى الله عليه و سلم أو من الصحابة؟ فقال: هو صادر من النبي صلى الله عليه و سلم، و هو الذي أمر الكتاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه الهيئة فما نقصوا و لا زادوا على ما سمعوه من النبي صلى الله عليه و سلم فقلت له: إن جماعة من العلماء ترخصوا في أمر الرسم، و قالوا: إنما هو اصطلاح من الصحابة مشوا فيه على ما كانت قريش تكتب عليه في الجاهلية، و إنما صدر ذلك من الصحابة لأن قريشا تعلموا الكتابة من أهل الحيرة، و أهل الحيرة ينطقون بالواو في «الربوا» فكتبوا على وفق منطقهم، و أما قريش فإنهم ينطقون فيه بالألف، و كتابتهم له بالواو على منطق غيرهم و تقليد لهم حتى قال القاضي أبو بكر الباقلاني: كل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه فإنه ليس في الكتاب و لا في السنة، و لا في الإجماع ما يدل على ذلك، فقال: ما للصحابة، و لا لغيرهم في رسم القرآن و لا شعرة واحدة، و إنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه و سلم و هو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف و نقصانها، و الأسرار لا تهتدي إليها العقول و هو سر من الأسرار خص اللّه به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية فلا يوجد شي ء من هذا الرسم لا في التوراة و لا في الإنجيل و لا في الزبور و لا في غيرها من الكتب السماوية، و كما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز، و كيف تهتدي العقول إلى سر
ص: 198
زيادة الألف في مائة دون فئة. و إلى سر زيادة الياء في: «بأييد و بأييكم». أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في: «سعوا» بالحج، و نقصانها من: «سعو» بسبإ، و إلى سر زيادتها في: «عتوا» حيث كان. و نقصانها من: «عتو» بالفرقان، و إلى سر زيادتها في آمنوا، و إسقاطها من: «باؤ، و جاؤ، و تبوؤ، و فاؤ» بالبقرة، و إلى سر زيادتها في: «يعفوا الذي»، و نقصانها من: «يعفو عنهم» في النساء.
أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة دون بعض كحذف الألف من: «قرءنا» بيوسف و الزخرف، و إثبات الألف في: «الميعاد» مطلقا، و حذفه من الموضع الذي في الأنفال، و إثبات الألف في: «سراجا» حيثما وقع، و حذفه من موضع الفرقان، و كيف تتوصل إلى فتح بعض التاءات و ربطها في بعض، فكل ذلك لأسرار إلهية و أغراض نبوية، و إنما خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني، فهي بمنزلة الألفاظ و الحروف المتقطعة التي في أوائل السور، فإن لها أسرارا عظيمة و معاني كثيرة و أكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها، و لا يدركون شيئا من المعاني الإلهية التي أشير إليها، فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفا بحرف، و أما قول من قال أن الصحابة اصطلحوا على أمر الرسم المذكور فلا يخفى ما في كلامه من البطلان، لأن القرآن كتب في زمان النبي صلى الله عليه و سلم، و بين يديه و حينئذ فلا يخلو ما اصطلح عليه الصحابة، إما أن يكون هو عين الهيئة أو غيرها فإن كان عينها بطل الاصطلاح لأن أسبقية التوقيف من النبي صلى الله عليه و سلم تنافي ذلك و توجب الاتباع، و إن كان غير ذلك فكيف يكون النبي صلى الله عليه و سلم كتب على هيئة كهيئة الرسم القياسي مثلا، و الصحابة خالفوا و كتبوا على هيئة أخرى فلا يصح ذلك لوجهين:
أحدهما: نسبة الصحابة إلى المخالفة و ذلك محال.
ثانيهما: أن سائر الأمة من الصحابة و غيرهم أجمعوا على أنه لا يجوز زيادة حرف في القرآن و لا نقصان حرف منه، و ما بين الدفتين كلام اللّه- عز
ص: 199
و جل-، فإذا كان النبي صلى الله عليه و سلم أثبت ألف «الرحمن، و العلمين» مثلا و لم يزد الألف في: «مائة» و لا في: «و لا أوضعوا» و لا الياء في: «بأييد» و نحو ذلك، و الصحابة عاكسوه في ذلك و خالفوه لزم أنهم- و حاشاهم من ذلك- تصرفوا في القرآن بالزيادة و النقصان، و وقعوا فيما لا يحل لأحد فعله، و لزم تطرق الشك إلى جميع ما بين الدفتين لأنا مهما جوزنا أن تكون فيه حروف ناقصة أو زائدة على ما في علم النبي صلى الله عليه و سلم و على ما عنده و أنها ليست بوحي و لا من عند اللّه، و لا نعلمها بعينها شككنا في الجميع، و لئن جوزنا لصحابي أن يزيد في كتابته حرفا ليس بوحي، لزمنا أن نجوز لصحابي آخر نقصان حرف من الوحي إذ لا فرق بينهما و حينئذ تنحل عروة الإسلام بالكلية.
و إنما من ادعى الاصطلاح من الصحابة يصح له أن يدعيه عليها إذا كانت كتابة القرآن في عصرهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم، و قد ثبت أن الرسم توقيفي لا اصطلاحي و أن النبي صلى الله عليه و سلم هو الآمر بكتابته على الهيئة المعروفة فقلت له: إن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يقرأ الكتابة و قد قال اللّه في وصفه: وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ فقال: كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يعرفها بالاصطلاح و لا بالتعليم من الناس.
فقلت له: فإن كان الرسم توقيفيّا بوحي إلى النبي صلى الله عليه و سلم و أنه كألفاظ القرآن فلم لم ينقل تواترا حتى ترفع عنه الريبة و تطمئن به القلوب كألفاظ القرآن فإنه ما من حرف إلا و قد نقل تواترا لم يقع فيه اختلاف و لا اضطراب.
و أما الرسم فإنه إنما نقل بالآحاد كما يعلم من الكتب الموضوعة فيه و ما نقل بالآحاد وقع الاضطراب بين النقلة في كثير منه.
و كيف تضيع الأمة شيئا من الوحي، فقال: ما ضيعت الأمة شيئا من الوحي و القرآن- بحمد اللّه- محفوظ ألفاظا و رسما فأهل العرفان و الشهود و العيان حفظوا ألفاظه و رسمه، و لم يضيعوا منهما شعرة واحدة و أدركوا ذلك بالشهود
ص: 200
و العيان الذي هو فوق التواتر، و غيرهم حفظوا ألفاظه الواصلة إليهم بالتواتر و اختلافهم في بعض حروف الرسم لا يقدح و لا يصير الأمة مضيعة كما لا يضر جهل العامة بالقرآن و عدم حفظهم لألفاظه.
و أما قول القاضي أبي بكر الباقلاني: ليس في الكتاب و لا في السنة و لا الإجماع و لا القياس ما يدل على وجوب اتباع المرسوم فجوابه يعلم مما سبق و حيث ثبت أن الرسم توقيفي فدليل الوجوب من الكتاب قوله تعالى: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، و من السنة فعله، أي: تقريره عليه الصلاة و السلام، و قوله، أي: أمره للصحابة، فقد أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعلومة، فإن زعم زاعم أنه لم يأمرهم بذلك فلا ينازع في تقريره عليه الصلاة و السلام لأن نصوص أئمة الاجتهاد، لم تزل طافحة بذلك مثل الإمام مالك و الإمام أحمد بن حنبل و غيرهما من أهل الاجتهاد. ا ه نقلا عن «الجوهر الفريد في رسم القرآن المجيد» بقلم مؤلفه ملخصا لذلك من كتاب «الذهب الإبريز» انتهى بتصرف يسير من كتاب «إرشاد القراء و الكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين».
ص: 201
تتمة في بيان بطلان ما ادعاه الملحدة من التغيير أو التحريف في القرآن
ما كتب في المصاحف العثمانية مأثور في السنة مستفيض بين الأمة، فلا يصح مع اشتهاره و توفر نقلته و كثرة حفاظه أن يكون فيه نقص أو زيادة أو تبديل أو أي تحريف عما سمعوه من في رسول اللّه صلى الله عليه و سلم، و إلى ذلك أشار العلامة الشاطبي- رحمه اللّه تعالى- في العقيلة بقوله:
و كل ما فيه مشهور بسنته و لم يصب من أضاف الوهم و الغير
فقد أخطأ الملحدة- و هم غلاة الشيعة- و ضلوا ضلالا بعيدا في قولهم إن القرآن العزيز غيّره الذين كتبوه في المصاحف و حرفوه عن هيئة إنزاله و حالة كماله و زادوا فيه و نقصوا منه، و قال بعضهم: نقصوا منه و لم يزيدوا فيه، قالوا: و قد كان فيه لعن قوم من الصحابة من قريش و غيرهم و كانوا مذكورين بأسمائهم و أنسابهم، و كان فيه أسماء الأئمة من أهل البيت و مدحهم، قالوا: و قد كان على غير هذا النظم و هذا التأليف و الذين جمعوه لم يتقنوه و لم يتيقنوه، إنما كانوا يأخذونه من الواحد و الاثنين و الرقاع و الأكتاف، و زعموا أن ذلك سبب اختلاف المصاحف و القراءات و فساد قولهم ظاهر لأن اللّه تعالى يقول: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ و لأن الاعتماد في نقل القرآن على الحافظ و قد كانوا عند كتابة الصحف و المصاحف أكثر من عدد التواتر مطلقا فلو غيره الكتاب كما زعموا لعلم من تلاوة القراء، و أيضا ولي علي رضي الله عنه الخلافة بعد الأئمة الثلاثة- رضي اللّه عنهم-، فلو صحت دعواهم لأقرأ الأئمة من أهل البيت القرآن على وجهه و كتب لهم مصحفا كذلك، و أثبت فيه ما ادعوا تغييره.
فإن قالوا: غصبوه مصحفه، فبإجماعنا و إجماعهم أنه كان حينئذ حافظا لجميع القرآن فهلا علمهم من حفظه.
ص: 202
فإن قالوا: ما كان متمسكا من إظهار، قيل: كان علمهم سرّا كالأحكام و لا تصح خلافته على مذهبهم.
و أما قولهم: أخذوه عن الآحاد و الرقاع و هو سبب الاختلاف، فقد علم رده مما تقدم في بيان جمع القرآن.
و نقول أيضا: كيف يصح تفريط الصدر الأول- رضي اللّه عنهم- في القرآن و إهمالهم لحفظه و نقله حتى ينسى فلا يعرفه إلا الواحد و الاثنان، و حتى لا يوجد إلا في الأكتاف و اللخاف مع شهرتهم في الدين و بذلهم الأنفس فيه و الأموال، فيتركون القرآن الذي فيه منافع دنياهم و أخراهم و قد آمنوا بقوله صلى الله عليه و سلم: «من قرأ القرآن فأعربه- أي بينه- فله بكل حرف منه عشر حسنات» و رأوا تعظيمه صلى الله عليه و سلم لأهل القرآن و تقديمه إياهم على غيرهم، و سمعوا ما ذكر في فضل حملة القرآن و أنهم أهل اللّه و خاصته، و ما ذكر في شفاعة القرآن، إلى غير ذلك من الأخبار، فالملحدة قوم بهت، أ لا تراهم ادعوا أن الحجاج غيّر مصحف عثمان أيضا و نقص منه و زاد فيه أحد عشر حرفا!! و أنه أخذ مصاحف أهل الكوفة من أيديهم و نشر فيهم ما زاده و نقصه!! فهذه الدعوى في ظهور فسادها بسبب كثرة القراء في زمن الحجاج و انتشار الأئمة و توفر النقلة كالدعوى الأولى في زيادة الصحابة في القرآن و النقصان منه مع كثرة القراء و توفر الحفاظ و النقص و الزيادة في الشي ء مع كثرة نقلته و توفر حملته محال، قال العلامة الجعبري في شرح العقيلة:
و أما الحجاج فقد حدثني بعض شيوخي أنه صلى بالناس جهرية فقرأ فيها وَ الْعادِياتِ فسبق لسانه إلى فتح إِنَّ رَبَّهُمْ فحذف لام لَخَبِيرٌ لئلا يلحن، فلما سلم قال لبعض من صلى معه من القراء: كيف وجدتني؟
فقال: وجدتك يا حجاج لحانا و بتارا- و الناس يسمعون-!! فمن لم يسمح له بسبق لسانه إلى حركة و بكت في ملئه، لا يخطر ببال عاقل أنهم يوافقونه على تغيير مصحف جعله عثمان رضي الله عنه لهم إماما.
ص: 203
و أيضا فالحجاج تولى أميرا على طرف في مدة فلو فعل ذلك لأنكره عليه إمامه، و أهل الحل و العقد من بقية الأقطار و لرجعوا عنه بعده. ا ه و كذلك ادعى قوم أن قوله تعالى: وَ قَضى رَبُّكَ أصلها: وصى ربك، فاتصل رأس الواو الثانية بالصاد في الكتابة فصحفوه وَ قُضِيَ و فساد دعواهم واضح، لأنه تواتر نقلها عن النبي صلى الله عليه و سلم، و قرأها عليه و سمعها منه الجم الغفير من الصحابة و أخذها التابعون عنهم، و طريق رواية القرآن عندنا الحفاظ لا الكتابة، فلا يضرنا اتصال الواو و إن صدقوا.
و أيضا يلزم على زعم أن مروان هو الذي قرأ: (ملك يوم الدين) من تلقاء نفسه و هذا كذب صريح، لأن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ مالِكِ بألف و بحذفها، و تواتر عنه الوجهان فممن قرأ بهما علي و أبي و ابن مسعود، و ممن قرأ بالقصر أبو الدرداء و ابن عباس و ابن عمر، و ممن قرأ بالمد أبو بكر و عمر و عثمان- رضي اللّه عنهم-، و ذلك كله قبل أن يولد مروان، بل اتفقت روايته القصر كما اتفقت رواية عمر بن عبد العزيز المد.
و أيضا يلزم من ذلك أن الأمة و الأئمة اتبعوا مروان فيما جاء به من عند نفسه، و مما يرد دعواهم و يوهن قواهم أن التبليغ كان واجبا على رسول اللّه صلى الله عليه و سلم: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ، فانتصب صلى الله عليه و سلم لتعليمه و بعث إلى من ليس بحضرته من يعلمه حتى انتشر في الأقطار التي دخلها الإسلام، و اشتهر في المواضع التي حل فيها الإيمان، أ لا ترى إلى قولهم: كان رسول اللّه صلى الله عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.
و قال عبد اللّه بن- مسعود رضي الله عنه-: تعلمت من في رسول اللّه صلى الله عليه و سلم سبعين سورة، و أمره اللّه- تعالى- أن يقرأ على أبي ليعلمه و يقتدي به في قراءته، و قال معاذ: عرضنا على رسول اللّه صلى الله عليه و سلم إذا أسلم الرجل أمره بقراءة القرآن قبل كل شي ء. قال عبادة بن الصامت: كان الرجل إذا هاجر دفعه رسول اللّه صلى الله عليه و سلم إلى
ص: 204
رجل منا يعلمه.
و قال عبادة أيضا: علمت رجلا من أهل الصفة القرآن و الكتابة، و بعث صلى الله عليه و سلم إلى المدينة قبل الهجرة مصعب بن عمير يعلمهم القرآن و انضاف إليه ابن أم مكتوم في الإقراء ثم تلاحق المهاجرون.
و لما فتح رسول اللّه صلى الله عليه و سلم مكة ترك فيها معاذ بن جبل لذلك و لم يزل المسلمون يدينون بتلاوة القرآن، و يرون ذلك من أفضل الأعمال في أول الإسلام و هلم جرا، و في قصة عمر يوم أسلم و تلاوة أخته سورة طه ما يدل على ذلك، و ما زال ذلك دأبهم أينما حلوا، و كذلك كانوا في أرض الحبشة و غيرها.
و قد كان لمسجد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم ضجة بتلاوة القرآن حتى أمرهم بخفض أصواتهم لئلا يغلظ بعضهم بعضا، فبطل بما ذكر جميع ما ذكروه. و اللّه أعلم.
انتهى ملخصا من شرحي الإمام أبي الحسن علي بن محمد السخاوي و المحقق أبي محمد إبراهيم بن عمر الجعبري على متن الرائية.
ص: 205
فائدة مهمة في ذكر بعض من عني بضبط القراءات و جمعها في الكتب و نشرها للأمة
قال ابن الجزري في النشر: أن القراء الذين أخذوا عن الأئمة المتقدمين من السبعة المشهورين و غيرهم كانوا أمما لا تحصى، و طوائف لا تستقصى، و الذين أخذوا عنهم أيضا أكثر و هلم جرا.
فلما كانت المائة الثالثة، و اتسع الخرق، و قلّ الضبط، و كان علم الكتاب و السنة أوفر ما كان في ذلك العصر تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات.
فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، و جعلهم- فيما أحسب- خمسة و عشرين قارئا مع هؤلاء السبعة، و توفي سنة أربع و عشرين و مائتين، و كان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي نزيل أنطاكية جمع كتابا في القراءات الخمسة من كل مصر واحد، و توفي سنة ثمان و خمسين و مائتين.
و كان بعده القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون، ألف كتابا في القراءات جمع فيه قراءات عشرين إماما، منهم هؤلاء السبعة، و توفي سنة اثنتين و ثمانين و مائتين.
و كان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري جمع كتابا حافلا سماه: الجامع، فيه نيف و عشرون قراءة، توفي سنة عشرة و ثلاثمائة.
و كان بعده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني جمع كتابا في القراءات، و أدخل معهم أبا جعفر أحد العشرة، و توفي سنة أربع و عشرين و ثلاثمائة، و كان في أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط، و روى فيه عن هذا الداجوني، و عن ابن جرير أيضا، و توفي سنة أربع و عشرين و ثلاثمائة.
ص: 206
و قام الناس في زمانه و بعده، فألفوا في القراءات أنواع التآليف كأبي بكر أحمد بن نصر الشذائي توفي سنة سبعين و ثلاثمائة، و أبي بكر أحمد بن أبي الحسين بن مهران مؤلف كتاب الشامل و الغاية و غير ذلك في قراءات العشرة، و توفي سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة، و الإمام الأستاذ أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي مؤلف الكتب في القراءات بحسب ما وصل إليهم و صح لديهم، كل ذلك و لم يكن بالأندلس و لا ببلاد الغرب شي ء من هذه القراءات إلى أواخر المائة الرابعة فرحل منهم من روى القراءات بمصر و دخل بها.
و كان أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد اللّه الطلمنكي مؤلف الروضة أول من أدخل القراءات إلى الأندلس، توفي سنة تسع و عشرين و أربعمائة، ثم تبعه أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي مؤلف التبصرة و الكشف و غير ذلك، و توفي سنة سبع و ثلاثين و أربعمائة، ثم الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني مؤلف التيسير و جامع البيان و غير ذلك، و توفي سنة أربع و أربعين و أربعمائة و كتاب جامع البيان له في قراءات السبعة فيه عنهم أكثر من خمسمائة رواية و طريق.
و كان بدمشق الأستاذ أبو على الحسن بن على بن إبراهيم الأهوازي مؤلف الوجيز و الإيجاز و الإيضاح و الاتضاح، و جامع المشهور و الشاذ، و لم يلحقه أحد في هذا الشأن، و توفى سنة ست و أربعين و أربعمائة.
و في هذه الحدود رحل من المغرب أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي إلى المشرق و طاف البلاد، و روى عن أئمة القراءات حتى انتهى إلى ما وراء النهر، و ألف كتابه الكامل جمع فيه خمسين قراءة عن الأئمة و ألفا و أربعمائة و تسعا و خمسين رواية و طريقا، قال فيه: فجملة من لقيت في هذا العلم ثلاثمائة و خمسة و ستين شيخا من آخر المغرب إلى آخر باب فرغانة يمينا و شمالا و جبلا و بحرا، و توفى سنة خمس و ستين و أربعمائة.
و في هذا العصر كان أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري بمكة
ص: 207
مؤلف كتاب التلخيص في القراءات الثماني و سوق العروس، فيه ألف و خمسمائة و خمسون رواية و طريقا، و توفى سنة ثمان و سبعين و أربعمائة، و هذان الرجلان أكثر من علمنا جمعا في القراءات، لا نعلم أحدا بعدهما جمع أكثر منهما إلا أبا القاسم عيسى بن عبد العزيز الإسكندري، فإنه ألف كتابا سماه الجامع الأكبر و البحر الأزخر، يحتوي على سبعة آلاف رواية و طريق، و توفى سنة تسع و عشرين و ستمائة.
و لا يزال الناس يؤلفون في كثير القراءات و قليلها و يروون شاذها و صحيحها بحسب ما وصل إليهم و صح لديهم، و لا ينكر أحد عليهم، بل هم في ذلك متبعون سبيل السلف حتى قالوا: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول و ما علمنا أحدا أنكر شيئا قرأ به الآخر، إلا ما قدمنا عن ابن شنبوذ لكونه خرج عن المصحف العثماني، و للناس في ذلك اختلاف، و كذا ما أنكر على ابن مقسم من كونه أجاز القراءة بما وافق المصحف من غير أثر كما قدمنا.
أما من قرأ بالكامل للهذلي أو سوق العروس للطبري أو إقناع الأهوازي أو كفاية أبي العز أو مبهج سبط الخياط، أو روضة المالكي أو نحو ذلك على ما فيه من ضعيف و شاذ عن السبعة و العشرة و غيرهم، فلا نعلم أحدا أنكر ذلك و لا زعم أنه مخالف لشي ء من الأحرف السبعة، بل ما زال علماء الأمة و قضاة المسلمين يكتبون خطوطهم و يثبتون شهادتهم في إجازاتهم بمثل هذه الكتب و القراءات.
و إنما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، أو أن الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى اللّه عليه و سلم هي قراءة هؤلاء السبعة بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية و التيسير، و أنها هي المشار إليها بقوله صلى اللّه عليه و سلم:
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» حتى أن بعضهم يطلق على ما لم يكن في
ص: 208
هذين الكتابين أنه شاذ و كثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذا.
و ربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية و التيسير و عن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيها، و إنما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا: أنزل القرآن على سبعة أحرف و سمعوا قراءات السبعة فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار إليها، و لذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء و خطئوه في ذلك، و قالوا: أ لا اقتصر على دون هذا العدد أو زيادة أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة.
قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي: فأما اقتصار أهل الأمصار في الأغلب على نافع و أبي عمرو و ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائي، فذهب إليه بعض المتأخرين اختصارا و اختيارا فجعله عامة الناس كالفرض المحتوم، حتى إذا سمع ما يخالفها خطأ أو كفر، و ربما كانت أظهر و أشهر.
ثم اقتصر من قلت عنايته على راويين لكل إمام منهم فصار إذا سمع رواية راو عنه غيرهما أبطلها و ربما كانت أشهر، و لقد فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لا ينبغي له أن يفعله، و أشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله و أوهم كل من قل نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير و أكدوهم اللاحق السابق، و ليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة.
و قال أيضا: القراءة المستعملة التي لا يجوز ردّها ما اجتمع فيها الثلاثة الشروط فما جمع ذلك وجب قبوله، و لم يسع أحدا من المسلمين ردّه سواء أ كانت عن أحد من الأئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أم غيرهم، و قال الإمام أبو محمد: و قد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة و أجل قدرا من هؤلاء السبعة على أنه قد ترك جماعة من العلماء
ص: 209
في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة و طرحهم، فقد ترك أبو حاتم و غيره ذكر حمزة و الكسائي و ابن عامر و زاد نحو عشرين رجلا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة، و كذلك زاد الطبري في كتاب القراءات على هؤلاء السبعة نحو خمسة عشر رجلا، و كذلك فعل أبو عبيد و إسماعيل القاضي.
فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم إحدى الحروف السبعة المنصوص عليها هذا اختلاف عظيم.
أ كان ذلك بنص من النبي صلى اللّه عليه و سلم أم كيف ذلك؟ و كيف يكون ذلك و الكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون أو غيره، و كان السابع يعقوب الحضرمي فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب، ثم أطال الكلام في تقرير ذلك.
و قال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني- بعد أن ساق اعتقاده في الأحرف السبعة و وجوه اختلافها، و أن القراء السبعة و نظراءهم من الأئمة متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها.
و قال أبو القاسم الهذلي في كامله: و ليس لأحد أن يقول: لا تكثروا من الروايات، و يسمى ما لم يصل إليه من القراءات شاذّا لأنه ما من قراءة قرئت، و لا رواية رويت إلا و هي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام و لم تخالف الاجماع، قلت: و قد وقفت على نص الإمام أبي بكر بن العربي في كتابه المقتبس على جواز القراءة و الاقراء بقراءة أبي جعفر و شيبة و الأعمش و غيرهم، و إنها ليست من الشاذة، و لفظه: و ليست هذه الروايات بأصل للتعيين بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها كحروف أبي جعفر المدني و غيره.
و كذلك رأيت نص الإمام أبي جعفر بن حزم في آخر كتاب السيرة.
و قال الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في أول تفسيره: ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن و حفظ حدوده،
ص: 210
فهم متعبدون بتلاوته و حفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفق الصحابة عليه و ألا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة و التابعين، و اتفقت الأمة على اختيارهم، قال: و قد ذكرت في هذا الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة و اختياراتهم على ما قرأته.
و ذكر إسناده إلى ابن مهران ثم سماهم فقال: و هم: أبو جعفر و نافع المدنيان و ابن كثير المكي، و ابن عامر الشامي، و أبو عمرو بن العلاء و يعقوب الحضرمي البصريان، و عاصم و حمزة و الكسائي الكوفيون.
ثم قال: فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها.
و قال الإمام الكبير الحافظ المجمع على قوله في الكتاب و السنة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسين الهمداني في أول غايته: أما بعد، فإن هذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم و تمسكوا فيها بمذهبهم من أهل الحجاز و الشام و العراق، ثم ذكر القراء العشرة.
و قال شيخ الإسلام و مفتي الأنام العلامة أبو عمرو عثمان بن الصلاح- رحمه اللّه- في جملة جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم ذكرها العلامة أبو شامة في كتابه «المرشد الوجيز» أشرنا إليها في كتابنا المنجد: يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قرآنا و استفاض نقله كله، و نقلته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع، لأن المعتبر في ذلك اليقين و القطع على ما تفرد و تمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع و كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة انتهى.
و لما قدم الشيخ أبو محمد عبد اللّه بن عبد المؤمن الواسطي بدمشق في حدود سنة ثلاثين و سبعمائة و أقرأ بها للعشرة بمضمن كتابيه الكتر و الكفاية و غير ذلك.
بلغنا أن بعض مقرئي دمشق ممن كان لا يعرف سوى الشاطبية و التيسير
ص: 211
حده و قصد منعه من بعض القضاة، فكتب علماء ذلك و أئمته في ذلك و لم يختلفوا في جواز ذلك.
و اتفقوا على أن قراءات هؤلاء العشرة واحدة، و إنما اختلفوا في إطلاق الشاذ على ما عدا هؤلاء العشرة و قد توقف بعضهم، و الصواب أن ما دخل في تلك الأركان الثلاثة فهو صحيح، و ما لا فعلى ما تقدم.
و كان من جواب الشيخ الإمام مجتهد ذلك العصر أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية- رحمه اللّه-: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة المشهورة؛ بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم.
و لهذا قال بعض أئمة القراء: لو لا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة، و إمام قراءة البصرة في زمانه في رأس المائتين، ثم قال- أعني ابن تيمية-: و كذلك لم ينازع علماء الإسلام المتبعون من السلف و الأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي و نحوهما، كما ثبتت عنده قراءة حمزة و الكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع و الخلاف، بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة و أحمد بن حنبل و بشر بن الحارث و غيرهم يختارون قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع و شيبة بن نصاح المدنيين، و قراءة البصريين كشيوخ يعقوب و غيرهم على قراءة حمزة و الكسائي.
و للعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء.
و لهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة و الأحد
ص: 212
عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب و يقرءونه في الصلاة و خارج الصلاة، و ذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم، و أما الذي ذكره القاضي عياض و من نقل كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة و جرت له قصة مشهورة، فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف و لم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة.
و لكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره لم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه، فإن القراءة- كما قال زيد بن ثابت-: سنة يأخذها الآخر عن الأول.
كما أن ما ثبت عن النبي صلى اللّه عليه و سلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة و من أنواع صفة الأذان و الإقامة و صفة صلاة الخوف و غير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه، أو من علم نوعا و لم يعلم بغيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمه، و ليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك، و لا أن يخالفه كما قال النبي صلى اللّه عليه و سلم: «لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» ... ثم بسط القول في ذلك، ثم قال في آخر جوابه: و تجوز القراءة في الصلاة و خارجها بالقراءة الثابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءات و ليست شاذة حينئذ. و اللّه أعلم.
و كان من جواب الإمام الحافظ أستاذ المفسرين أبي حيان محمد بن يوسف بن حيان الجياني الأندلسي- رحمه اللّه تعالى-، و من خطه نقلت: قد ثبت لنا بالنقل الصحيح أن أبا جعفر شيخ نافع، و أن نافعا قرأ عليه و كان أبو جعفر من سادة التابعين و هما بمدينة الرسول صلى اللّه عليه و سلم حيث كان العلماء متوافرين و أخذ قراءته عن الصحابة عبد اللّه بن عباس ترجمان القرآن و غيره.
و لم يكن من هو بهذه المثابة ليقرأ كتاب اللّه بشي ء محرم عليه، و كيف
ص: 213
و قد تلقن ذلك في مدينة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عن صحابته غضّا رطبا قبل أن تطول الأسانيد و تدخل فيها النقلة غير الضابطين، هذا و هم عرب آمنون من اللحن.
و أن يعقوب كان إمام الجامع بالبصرة يؤم الناس و البصرة إذ ذاك ملأى من أهل العلم و لم ينكر أحد عليه شيئا من قراءته، و يعقوب تلميذ سلام الطويل، و سلام تلميذ أبي عمرو و عاصم، فهو من جهة أبي عمرو كأنه مثل الدوري الذي روى عن اليزيدي عن عمرو، و من جهة عاصم كأنه مثل العليمي و يحيى اللذين رويا عن أبي بكر عن عاصم. و قرأ يعقوب أيضا على غير سلام.
ثم قال: و هل هذه المختصرات التي بأيدي الناس اليوم كالتيسير و التبصرة و العنوان و الشاطبية بالنسبة لما اشتهر من قراءات الأئمة السبعة إلا نزر من كثير، و قطرة من قطر، و نشأ الفقيه الفروعي فلا يروى إلا مثل الشاطبية و العنوان، فيعتقد أن قراءات السبعة محصورة في هذا فقط، و من كان له اطلاع على هذا الفن رأى أن هذين الكتابين و نحوهما في السبعة كنغبة من دأماء، و تربة من بهماء.
هذا أبو عمرو بن العلاء الإمام الذي يقرأ أهل الشام و مصر بقراءته اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة اليزيدي و عنه رجلان: الدوري و السوسي و عند أهل النقل اشتهر عنه في غير هذه الكتب سبعة عشر راويا:
اليزيدي، و شجاع، و عبد الوارث، و العباس بن الفضل، و سعيد بن أوس، و هارون الأعور، و الخفاف، و عبيد بن عقيل، و الحسين الجعفي، و يونس بن حبيب، و اللؤلؤي، و محبوب، و خارجة، و الجهمي، و عصمة، و الأصمعي، و أبو جعفر الرواسي، فكيف يقصد قراءة أبي عمرو على اليزيدي، و يلغي من سواه من الرواة على كثرتهم و ضبطهم و ديانتهم و ثقتهم. و ربما يكون فيهم من هو أوثق و أعلم من اليزيدي.
و ننتقل إلى اليزيدي فنقول: اشتهر ممن روى عن اليزيدي الدوري
ص: 214
و السوسي و أبو حمدون و محمد بن أحمد بن جبير و أوقية أبو الفتح و أبو خلاد و جعفر بن حمدان سجادة و ابن سعدان و أحمد بن محمد اليزيدي، و أبو الحارث الليث بن خالد، فهؤلاء عشرة فكيف يقتصر على أبي شعيب و الدوري و يلغي بقية هؤلاء الرواة الذين شاركوهما في اليزيدي؟! و ربما فيهم من هو أضبط منهما و أوثق.
و ننتقل إلى الدوري فنقول: اشتهر ممن روى عنه: ابن فرح و ابن بشار و أبو الزعراء و ابن مسعود السراج و الكاغدي و ابن برزة و أحمد بن حرب المعدل.
و ننتقل إلى ابن فرح فنقول: روى عنه ممن اشتهر: زيد بن بلال و عمر ابن عبد الصمد، و أبو العباس محرز و أبو محمد القطان و المطوعي، و هكذا ننزل هؤلاء القراء طبقة طبقة إلى زماننا هذا.
و هكذا نافع الإمام الذي يقرأ أهل المغرب بقراءته اشتهر عنه تسعة رجال: ورش، و قالون، و إسماعيل بن جعفر، و أبو خليد، و ابن جماز، و خارجة، و الأصمعي، و كردم، و المسيبي، و هكذا كل إمام من باقي السبعة قد اشتهر عنه رواة غير من في هذه المختصرات فكيف يلغى نقلهم، و يقتصر على اثنين، و أي مزية و شرف لذينك الاثنين على رفقائهم و كلهم أخذوا عن شيخ واحد و كلهم ضابطون ثقات.
و قال الإمام مؤرخ الإسلام و حافظ الشام و شيخ المحدثين و القراء أبو عبد اللّه محمد بن أحمد الذهبي في ترجمة ابن شنبوذ من طبقات القراء له: أنه كان يرى جواز القراءة بالشاذ، و هو ما خالف رسم المصحف الإمام مع أن الخلاف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديما و حديثا و ما رأينا أحدا أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب و أبي جعفر، و إنما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفتين، و قال الحافظ أبو عمرو الداني صاحب التيسير في طبقاته:
و ائتم بيعقوب في اختباره عامة البصريين بعد أبي عمرو، فهم أو أكثرهم
ص: 215
على مذهبه، قال: و قد سمعت طاهر بن غلبون يقول: إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب.
و قال الإمام أبو بكر بن أشتة الأصبهاني، و على قراءة يعقوب إلى هذا الوقت أئمة المسجد الجامع بالبصرة، و كذلك أدركناهم.
و قال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي- بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن أحرف هؤلاء الأئمة السبعة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه و سلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» و أن الناس إنما ثمنوا القراءات و عشروها و زادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبه.
ثم قال: و إني لم أقتف أثرهم تثمينا في التصنيف أو تعشيرا أو تفريدا إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة.
و ليعلم أنه ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددا من الرجال دون آخرين و لا الأزمنة و لا الأمكنة، و أنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأئمة، و اختلس كل واحد منهم حروفا بخلاف صاحبه، و جرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان، و في أي أوان بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار لما كان ذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع إلى يوم القيامة.
و قال الشيخ الإمام العالم الولي موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف الكوشي الموصلي في أول تفسيره «التبصرة»: و كل ما صح سنده و استقام وجهه في العربية و وافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها، و لو رواه سبعون ألفا مجتمعين أو متفرقين فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو عن سبعة آلاف، و متى فقد واحد من هؤلاء الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة انتهى.
و قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الشافعية و المحقق للعلوم الشرعية أبو
ص: 216
الحسن علي بن عبد الكافي السبكي في شرح المنهاج في صفة الصلاة:
فرع: قال أصحابنا الفقهاء: تجوز القراءة في الصلاة و غيرها بالقراءات السبع و لا تجوز بالشاذة و ظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ لا تجوز القراءة به في الصلاة و لا في غيرها، و قد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب و أبي جعفر مع السبعة المشهورة، قال: و هذا القول هو الصواب.
و اعلم أن الخارج عن السبعة المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة و لا في غيرها، و منه ما لا يخالف رسم المصحف و لم تشتهر القراءة به، و إنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها، و هذا يظهر المنع من القراءة به أيضا، و منه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما و حديثا فهذه للمنع منه، و من ذلك قراءة يعقوب و غيره، قال: و البغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم.
قال: و هكذا التفصيل في شواذ السبعة فإن عنهم شيئا كثيرا شاذّا انتهى.
و سئل العلامة قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب- رحمه اللّه تعالى- عن قوله في كتابه جمع الجوامع في الأصول: و السبع متواترة مع قوله:
و الصحيح أن ما وراء العشر فهو شاذ إذا كانت العشر متواترة، فلم لا قلتم:
و العشر متواترة، بدل قولكم: و السبع؟ فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها؛ فلأن السبع لم يختلف في تواترها، و قد ذكرنا أولا موضع الإجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط و لا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين، و هي القراءات الثلاث: قراءة يعقوب و أبي جعفر بن القعقاع و خلف لا تخالف رسم المصحف.
ثم قال: سمعت الشيخ الإمام- يعني: والده- يشدد النكير على بعض
ص: 217
القضاة و قد بلغه أنه منع من القراءة بها، و استأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع، فقال: أذنت لك أن تقرئ العشر. ا ه قال المحقق ابن الجزري: و قد جرى بيني و بينه في ذلك كلام كثير و قلت له: كان ينبغي أن تقول: و العشر متواترة و لا بد، فقال: أردنا التنبيه على الخلاف، فقلت: و أين الخلاف و أين القائل به، و من قال إن قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف غير متواترة؟ فقال: يفهم من قول ابن الحاجب: و السبع متواترة، فقلت: أي سبع؟ و على تقدير أن يكون هؤلاء السبعة- مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه- فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم، بل و لا عن قراءة الكوفيين في حرف، فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع إذعانه بتواتر السبع؟ و أيضا فلو قلنا إنه يعني هؤلاء السبعة فمن أي رواية و من أي طريق و من أي كتاب؟ إذ التلخيص لم يدعه ابن الحاجب و لو ادّعاه لما سلم له.
بقي الإطلاق، فيكون كل ما جاء عن السبعة، فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم و أبي عمرو، و أبي جعفر هو شيخ نافع و لا تخرج عن السبعة من طريق أخرى، فقال: فمن أجل هذا قلت: و الصحيح أن ما وراء العشر فهو شاذ، و لا يقابل الصحيح إلا الفاسد، ثم كتبت له استفتاء في ذلك و صورته:
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم هل هي متواترة أو غير متواترة؟
و هل كل ما انفرد به واحد من العشرة من الحروف متواتر أم لا؟
و إذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفا منها؟ فأجابني و من خطه نقلت-: الحمد للّه. القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي، و الثلاث التي هي قراءة أبي جعفر و قراءة يعقوب و قراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة، و كل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول اللّه صلى الله عليه و سلم لا يكابر في شي ء من ذلك إلا جاهل،
ص: 218
و ليس تواتر شي ء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا رسول اللّه، و لو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا، و لهذا تقرير طويل و برهان عريض لا تسع هذه الورقة شرحه، و حظ كل مسلم و حقه أن يدين اللّه- تعالى- و تجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا تتطرق الظنون و لا الارتياب إلى شي ء منه. و اللّه أعلم. كتبه عبد الوهاب السبكي الشافعي.
و قال الإمام الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في أول كتابه الشافي: ثم التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر و لا سنة، و إنما هو من جماع بعض المتأخرين لم يكن قرأ بأكثر من السبع، فصنف كتابا و سماه السبع، فانتشر ذلك عند العامة و توهموا أنه لا تجوز الزيادة على ما ذكر في ذلك الكتاب لاشتهار ذكر مصنفه، و قد صنف غيره كتبا في القراءات بعده، و ذكر لكل إمام من هؤلاء الأئمة روايات كثيرة و أنواعا من الاختلاف، و لم يقل إنه لا تجوز القراءة بتلك الرواية من أجل أنها غير مذكورة في كتاب ذلك المصنف، و لو كانت القراءات محصورة بسبع روايات لسبعة من القراء لوجب ألا يؤخذ عن كل واحد منهم إلا رواية واحدة و هذا لا قائل به.
و ينبغي أن لا يتوهم متوهم في قوله صلى الله عليه و سلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أنه منصرف إلى قراءة سبعة من القراء الذين ولدوا بعد التابعين، لأنه يؤدي إلى أن يكون الخبر متعريا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء الأئمة السبعة فتؤخذ عنهم القراءة و يؤدي أيضا إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا و تعلموا اختاروا القراءة به، و هذا تجاهل من قائله.
قال: و إنما ذكرت ذلك لأن قوما من العامة يقولون جهلا و يتعلقون
ص: 219
بالخبر و يتوهمون أن معنى السبعة الأحرف المذكورة في الخبر اتباع هؤلاء الأئمة السبعة، و ليس ذلك على ما يتوهمونه، بل طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة لفظا عن لفظ، إماما عن إمام إلى أن يتصل بالنبي صلى الله عليه و سلم، و اللّه أعلم بجميع ذلك.
تنبيه: في بيان أن القراءات السبع المشهورة ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن تحصل مما هنا، و مما تقدم أن القراءات المنسوبة إلى نافع و عاصم و غيرهما من باقي السبعة المشهورين ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن، و ذلك باتفاق علماء السلف و الخلف، و أنها ليست مجموع الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين، بل القراءات الثابتة عن أئمة القراء كالأعمش و يعقوب و خلف و أبي جعفر و شيبة و نحوهم هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من يثبت ذلك عنده، و هذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبعون من أئمة الفقهاء و القراء و غيرهم، و إنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و سلم و التابعون لهم بإحسان و الأئمة بعدهم هل هو بما فيه من قراءة السبعة و تمام العشرة و غير ذلك حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها، أو هو مجموع الأحرف السبعة؟ على قولين مشهورين. اه من النشر.
ص: 220
ذكر بعض القراءات الموافقة لخط المصحف و ليست من القراءات السبع المشهورة
و قال الإمام أبو محمد مكي في إبانته: ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة في سورة الحمد مما يوافق خط المصحف و يقرأ به:
قرأ إبراهيم بن أبي عبلة: الْحَمْدُ لِلَّهِ بضم اللام الأولى، و قرأ الحسن البصري بكسر الدال و فيها بعد في العربية و مجازهما الاتباع.
و قرأ أبو صالح: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ بالألف و النصب على النداء.
و كذلك محمد بن السميفع اليماني، و هي قراءة حسنة.
و قرأ أبو حيوة: (ملك) بالنصب على النداء من غير ألف.
و قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ملك يوم الدين) ففتح اللام و الكاف و نصب (يوم) جعله فعلا ماضيا.
و روى عبد الوارث عن أبي عمرو: (ملك يوم الدين) بإسكان اللام و الخفض و هي منسوبة لعمر بن عبد العزيز.
و قرأ عمرو بن قائد الأسواري: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بتخفيف الياء فيهما، و قد كره ذلك بعض المتأخرين لموافقة لفظه لفظ إيا للشمس و هو ضياؤها.
و قرأ يحيى بن وثاب: نَسْتَعِينُ بكسر النون الأولى و هي لغة مشهورة حسنة و روى الخليل بن أحمد عن ابن كثير: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ بالنصب، و نصبه حسن على الحال أو على الصفة.
و قرأ أيوب السختياني: وَ لَا الضَّالِّينَ بهمزة مفتوحة في موضع الألف و هو قليل في كلام العرب، فهذا كله موافق لخط المصحف، و القراءة به لمن رواه عن الثقات جائزة لصحة وجهه في العربية و موافقته الخط إذا صح نقله.
قلت: كذا اقتصر على نسبة هذه القراءات لمن نسبها إليه و قد وافقهم عليها غيرهم، و بقيت قراءات أخرى عن الأئمة المشهورين في الفاتحة توافق
ص: 221
خط المصحف و حكمها حكم ما ذكر، ذكرها الإمام الصالح الولي أبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح له.
و هي الْحَمْدُ لِلَّهِ بنصب الدال عن زيد بن علي بن الحسين بن علي- رضي اللّه عنهم-.
و عن رؤبة بن العجاج و عن هارون بن موسى العتكي و وجهها النصب على المصدر و ترك فعله للشهرة.
و عن الحسن أيضا: الْحَمْدُ لِلَّهِ بفتح اللام اتباعا لنصب الدال، و هي لغة بعض قيس و إمالة الألف من لِلَّهِ لقتيبة عن الكسائي و وجهها الكسرة بعد.
و عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري: رَبِّ الْعالَمِينَ بالرفع و النصب و حكاه عن العرب، و وجهه أن النعوت إذا تتابعت و كثرت جازت المخالفة بينها، فينصب بعضها بإضمار فعل، و يرفع بعضها بإضمار المبتدأ، و لا يجوز أن ترجع إلى الجر بعد ما انصرفت عنه إلى الرفع و النصب.
و عن الكسائي في رواية سؤدد بن المبارك و قتيبة: (ملك يوم الدين)، و عن عاصم الجحدري: (ملك) بالرفع و الألف منونا و نصب: (يوم الدين) بإضمار المبتدأ و إعمال (مالك) في (يوم).
و عن عون بن أبي شداد العقيلي: مالِكِ بالألف و الرفع مع الإضافة، و رفعه بإضمار المبتدأ و هي أيضا عن أبي هريرة و أبي حيوة و عمر بن عبد العزيز- رضي اللّه عنهم-.
و عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ملّاك يوم الدين) بتشديد اللام مع الخفض و ليس ذلك بمخالف للرسم بل يحتمله تقديرا كما تحتمله قراءة مالِكِ.
و على ذلك قراءة حمزة و الكسائي: (علام الغيب).
و عن اليماني أيضا: (مليك يوم) بالياء و هي موافقة للرسم أيضا كتقدير الموافقة في جبريل و ميكائيل بالياء و الهمزة، و كقراءة أبي عمرو: (و أكون من
ص: 222
الصالحين) بالواو.
و عن الفضل بن محمد الرقاشي: (أياك نعبد و أياك) بفتح الهمزة فيهما و هي لغة، و رواها سفيان الثوري عن علي أيضا.
و عن أبي عمرو في رواية عبد اللّه بن داود الخريبي إمالة الألف فيهما و وجه ذلك الكسرة من قبل، و عن بعض أهل مكة: (نعبد) بإسكان الدال، و وجهها التخفيف كقراءة أبي عمرو: (يأمركم) بالإسكان و قيل إنها عندهم رأس آية، فنوى الوقف للسنة و حمل الوصل على الوقف.
و روى الأصمعي عن أبي عمرو: (الزراط) بالزاي الخالصة، و جاء أيضا عن حمزة، و وجه ذلك أن حروف الصفير يبدل بعضها من بعض و هي موافقة للرسم كموافقة قراءة السين.
و عن عمر رضي الله عنه: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ بالرفع أي: هم غير المغضوب، أو:
أولئك.
و عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج و مسلم بن جندب و عيسى بن عمر الثقفي البصري و عبد اللّه بن يزيد القصير: عَلَيْهِمْ بضم الهاء و وصل الميم بالواو.
و عن الحسن و عن عمرو بن قائد: عَلَيْهِمْ بكسر الهاء و وصل الميم بالياء.
و عن ابن هرمز أيضا بضم الهاء و الميم من غير صلة، و عنه أيضا بكسر الهاء و الميم من غير صلة، فهذه أربعة أوجه، و في المشهور ثلاثة فتصير سبعة و كلها لغات.
و ذكر أبو الحسن الأخفش فيها ثلاث لغات أخرى لو قرئ بها لجاز و هي ضم الهاء و كسر الميم مع الصلة.
و الثانية كذلك إلا أنه بغير صلة، و الثالثة بالكسر فيهما من غير صلة و لم يختلف عن أحد منهم في الإسكان وقفا.
ص: 223
قلت: و بقي منها روايات أخرى رويناها منها إمالة الْعالَمِينَ و الرَّحْمنِ بخلاف لقتيبة عن الكسائي.
و منها إشباع الكسرة من: (ملك يوم) قبل الياء حتى تصير ياء و إشباع الضمة من: نَعْبُدُ و إِيَّاكَ حتى تصير واوا رواية كردم عن نافع، و رواها أيضا الأهوازي عن ورش و لها وجه.
و منها: يَعْبُدُ بالياء و ضمها و فتح الباء على البناء للمفعول قراءة الحسن و هي مشكلة، و توجه على الاستعارة و الالتفات. ا ه بتصرف يسير.
ص: 224
الخاتمة في الكلام على الكتابة و أنواعها و حكمها و ثمرها و أول من وضعها و ما يتعلق بذلك
اشارة
فالكتابة و الكتاب و الكتب مصادر كتب إذا خط بالقلم يقال: كتب قرطاسا أي خط فيه بالقلم حروفا، و ضمها أي جمع بعضها إلى بعض، و تطلق الكتابة أيضا على نفس الحروف المكتوبة، و الخط تصوير اللفظ بحروف هجائية بتقدير الابتداء به و الوقف عليه، و الهجاء اللفظ بأسماء الحروف لا مسمياتها لبيان مفرداتها، و من ثم رسمت همزة الوصل و ألف لكِنَّا هُوَ دون التنوين و واو الصلة و يائها، فإن كان مسمى اللفظ لفظا نحو اكتب كلمة أو شعرا فإن دلت قرينة على إرادة اللفظ كتب، و إلا فما ينطبق عليه الاسم، و كذا إذا قيل اكتب جيما عينا فاء راء، و أنواعها اثنا عشر على ما قاله ابن خلكان و تبعه كثير من المؤلفين، خمسة منها ذهب من يعرفها و بطل استعمالها و هي: الحميرية و القبطية و البربرية و الأندلسية و اليونانية، و ثلاثة منها فقد من يعرفها في بلاد الإسلام مستعملة في بلادها، و هي: الهندية و الصينية و الرومية، و أربعة باقية مستعملة في بلاد الإسلام و هي: السريانية و الفارسية و العبرانية و العربية.
قال: و الحميرية هي خط أهل اليمن قوم هود، و هم عاد الأولى و هي عاد إرم و كانت تسمى المسند الحميري، و كانت حروفها منفصلة و كانوا يمنعون العامة من تعلمها فلا يتعاطاها أحد إلا بإذنهم، حتى جاءت دولة الإسلام.
و حكم الكتابة من حيث الجملة الجواز، و هو الذي عليه جمهور العلماء، قال أبو الحسن اللخمي: هذا هو الصحيح و لا ينبغي أن يختلف فيه لتقاصر الأعصار و قلة الأفهام.
و قد روي عن بعض السلف الكراهة خيفة الاتكال على الكتابة و ترك
ص: 225
الحفظ.
و قد قيل لبعضهم: هل كنتم تكتبون العلم و الحديث؟ فقال: نعم، فقيل له: هل كنتم تعولون عليه؟ فقال: لا.
و ما ذلك إلا لرجحان عقولهم، فنسأل اللّه- عز و جل- أن يمنّ علينا ببعض ما منّ به عليهم بمنه و كرمه.
و من كلام العلماء في هذا المعنى قولهم: خير الفقه ما حضرت به، و قولهم: حرف في قلبك خير من ألف في كتابك.
و قولهم: لا خير في كلام لا يعبر معك الوادي و لا يعمر بك النادي.
و قال الشاعر:
يا من يرى العلم جمع المال ***خدعت و اللّه ليس الجد كاللعب
العلم ويحك ما للصدر تجمعه*** حفظا و فهما و اتفاقا فداك أبي
لا ما توهمه العندي من سفه*** إذ قال ما تبتغي عندي و في كتبي
و قال الآخر:
ليس العلم ما حوى القمطر إنما العلم ما حوى الصدر
و الأصل فيها كلام اللّه- تعالى- و كلام الرسول صلى الله عليه و سلم و كلام العرب و كلام العلماء، فمن كلام اللّه قوله تعالى: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً، فقيل: الحكمة هاهنا هي الكتابة، و قوله تعالى: أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ فقيل: الخط أيضا، و قوله تعالى: ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ و قوله تعالى: اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ فوصف نفسه بأنه علم بالقلم كما وصف نفسه بالكرم- سبحانه و تعالى-، و قوله تعالى: الم* ذلِكَ الْكِتابُ، و قوله تعالى: وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ.
ففي كلامه- تعالى- إرشاد إلى أن كلامه الموحى إلى رسله طريق تخليده تدوينه في الصحف.
ص: 226
و من كلام الرسول صلى الله عليه و سلم ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «قيدوا العلم بالكتابة».
و ما روي عن ابن عباس- رضي اللّه عنهما- أنه شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم سوء حفظه فقال له صلى الله عليه و سلم: «استعن بيمينك على حفظك».
و ما روي عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أنه قال للنبي صلى الله عليه و سلم: أ فأكتب عنك كل ما أسمع منك يا رسول اللّه؟ فقال له: «نعم». فقال: و إن كان في الغضب و الرضا؟ فقال: «و إن كان في الغضب و الرضا فإني لا أقول إلا حقّا».
و ما ورد في جمال الخط من قوله صلى الله عليه و سلم: «الخط الجميل يزيد في الحق وضوحا» فكلام الرسول أكد ما أرشد إليه كلام اللّه تعالى.
و من كلام العرب قولهم: الخط أحد اللسانين، و حسنه أحد الفصاحتين.
و قولهم: ما كتب قر و ما حفظ فرّ.
و من كلام العلماء ما أنشده سحنون رضي الله عنه:
العلم صيد و الكتابة قيد*** قيد صيودك بالقيود الموثقة
فمن الحماقة أن تصيد حمامة ***و تثيرها بين الأوانس مطلقة
و قول الآخر:
تعلم قوام الخط يا ذا ***و باه به النساخ في كل مكتب
فإن كنت ذا مال فخطك*** و إن كنت ذا فقر فأفضل مكسب
و ثمرتها: تثبيت الحفظ و تقرير الفهم و إذهاب النسيان و توصيل العلم و حفظه من الضياع، فهي تذكرة يرجع إليها عند النسيان، لأنه لا يطرأ عليها ما يطرأ على الأذهان لا على أنها المعتمد، بل تكون لرد الشارد كالمستند، و لقد أحسن من قال: الكتابة من أجل صناعة البشر و أعلى شأن، و من أعظم منافع الخلق من الإنس و الجان؛ لأنها حافظة لما يخاف عليه من النسيان، و قاضيته بالصواب من القول إذا حرف اللسان.
ص: 227
و قال آخر: لو لا ما عقدته بالكتابة من تجاريب الأولين؛ لانحل مع النسيان عقود الآخرين.
و قد أخطأ من اعتمد على حفظه و غفل عن تقييد العلم في كتبه ثقة بما استقر في نفسه؛ لأن التشكيك معترض و النسيان طارئ.
فكان عمر بن عبد العزيز- رحمه اللّه- يصلي بالليل فإذا مرت به آية فهم منها شيئا سلم من صلاته و كتبه في لوح أعده ليعمل به في غده.
و قال بعضهم: الكتابة سبب لتخليد كل فضيلة، و ذريعة إلى توريث كل حكمة جليلة، و موصلة لنا ما تلفظ به الحكماء من الألفاظ الجميلة، و مبلغة إلى الأمم الآتية أخبار القرون الخالية، و معارف الأمم الماضية، تخاطبك بلسان الحال عند تعذر المقال، كان الميت منهم حيّا بهذا الاعتبار، و المفقود موجودا بتجدد الأخبار، حتى كان الخالف يشاهد السالف، و الجاهل يأخذ عن العارف، فمتى أردت مجالسة إمام من الأئمة الماضين، و محادثة شيخ من شيوخ المتقدمين، فانظر في كتبه التي صنفها، و مجموعاته التي ألفها، و نوادره التي رسمها، و حكمه التي أحكمها، فإنك تجده مخاطبا لك و معلما و مرشدا و مفهما مع ما يحصل لك من الأنس بكتابه و ما تستفيده من حكمه و صوابه، و للّه در القائل- رحمه اللّه- في وصف الكتب:
لنا جلساء لا يمل حديثهم*** ألباء مأمونون غيبا و مشهدا
يفيدوننا من علمهم علم ما ***و عقلا و تأديبا و رأيا مسددا
فلا فتنة تخشى و لا سوء ***و لا نتقى منهم لسانا و لا
فإن قلت أحياء فلست ***و إن قلت أموات فلست
و قال غيره:
نعم الأنيس و الجليس كتاب*** تسلو به إن خانت
لا مفشيا سرّا إذا استودعته ***و به لعمري حكمة
ص: 228
و قال بعضهم: الكتابة منزلة شريفة، و حكمة في البيان لطيفة، فإن كان صاحبها ذا لسان و خط حسن و بيان اجتمع فيه حكمتان، و تحصل له فصاحتان: حكمة في يده و حكمة في لسانه، و فصاحة في لسانه و فصاحة في جنانه، و لم تر الفضلاء من كل جيل و النبلاء من كل قبيل يدونون ما يقع لهم من الكلمات النافعة و الحكم الجامعة، و يسارعون إلى حفظها بالكتابة خوفا من ذهابها بالنسيان أشد المسارعة نظما و نثرا، حتى نشرت في العلم نشرا، فكم من كلمة قد نفع اللّه بها بعد قائلها، و فائدة قد خبئت بالكتابة لمتناولها، و كم من حكم رائقة و موعظة جامعة و حجة بالغة و عبرة صادقة قد خزنها الأول للآخر، و نقشها في الحجارة بعد الدفاتر، حنوا من هذا البشر الذي يرحم بعضه بعضا، و يدل على ما يختاره لنفسه و يرضى، و قد دونوا أخبار الأجواد، و كتبوا مواقف الشجعان، علما بأن الناس يقتدي بعضهم ببعض، قال بعضهم في الحث على التكرم و عدم إغفاله رحمه اللّه- و من نسج منواله:
إني سألت عن الكرام فقيل لي*** إن الكرام رهائن الأرماس
ذهب الكرام وجودهم و نوالهم ***و حديثهم إلا من القرطاس
و لقد بالغ الناس في تخليد المواعظ و الحكم و الأمثال فنظموها في الأسفار و نقشوها على الأحجار بجدران الجوامع و فظان المجامع:
قال العلامة أبو الحسن علي بن محمد السخاوي: و قد رأيت في جامع بلدنا على بعض سواريه الرخام منقوشا بالحديد:
حضر في هذا الموضع المبارك سليمان بن كعب الأحبار و هو يقول: من خان هان إلى أن قال: و قد كتب الناس على الجدران و القبور و في الأحجار من المواعظ ما لا يكاد يحصى، و مما رأيت أنا من ذلك على قبر ابن عبادة بمصر- رحمه اللّه تعالى-:
يا ماشيا بالقبور زهوا ***لم تثنه للقبور ريح
ص: 229
عرج عليلا على غريب*** قد ضمه مفردا ضريح
بيت تساوى الأنام فيه*** العبد و السيد الصريح
وقف عليه وجد يرجى*** لعله فيه يستريح
و رأيت على سارية ببعض أطراف مصر بمدينة قد تداعت أرجاؤها و تقوض بناؤها و جلا عنها سكانها:
رعى اللّه من يدعو لنا في طريقنا بصنع جميل و الرجوع إلى مصر
و من رأى ما قد كتبناه دارسا أعاد عليه بالمداد أو الحبر
و لذا قال اللبيب في شرح العقيلة: قد صنف المصنفون من هذه الأمة كتبا ما لها عدد في كل فن.
أخبرني سيدي الشيخ يوسف القادسي أنه رأى في غرناطة عند بعض الطلبة كتابا ضخما في القالب الكبير و على ظهر الكتاب مكتوب: السفر السادس و الخمسون من أسماء الكتب، و لم ير ما بقي بعده، ليس في هذا السفر إلا اسم الكتاب و اسم مؤلفه و بلده و زمانه خاصة.
فانظر كم تضمنت هذه الأسفار عدة أسماء كتب. ا ه و غير ذلك مما يفيد الحث على الكتابة من كلام الحكماء كثير لا يحصيه لسان و لا يسعه ديوان، فلو لا الكتابة ما وصل كلام الأوائل إلينا و لا بلغ علمهم لدينا.
و لما كان كل من أراد إبقاء حكمة أو تخليد علم أو فضيلة لا يجد لذلك أقوى من كتبه و لا أوثق من رسمه، و كان كتاب اللّه- عز و جل- أولى بذلك من كل كتاب و أحق به من كل خطاب.
كان الصحابة- رضي اللّه عنهم- يكتبون ما يسمعونه من في رسول اللّه صلى الله عليه و سلم من القرآن في الصحائف و الرقاع مخافة النسيان و الضياع إلى أنه اقتضى رأيهم الصائب جمعه في المصاحف لتكون رقيمة يهتدى بها و يرجع إليها و يرتفع الخلاف معها و النزاع عندها، فينبغي لنا معرفة كيفية رسمهم ذلك
ص: 230
لنعمل بالموافق و نترك المخالف.
إذ اتباعهم واجب علينا لا محالة و مخالفتهم بدعة و ضلالة، و أول من وضعها آدم- عليه السلام- ... خرج ابن أشتة في كتاب المصاحف بسنده عن كعب الأحبار، قال: أول من وضع الكتاب العربي و السرياني و الكتب كلها- يعني الاثني عشر المتقدم بيانها- آدم- عليه السلام- كتبها- أي تلك الخطوط- في طين و طبخه- يعني أحرقه- و دفنه قبل موته بثلاثمائة سنة، فلما أصاب الأرض الغرق في زمن نوح- عليه السلام- بقيت تلك الكتب و الخطوط، فبعد الطوفان أصاب كل قوم كتابا فتعلموه بإلهام و نقلوا صورته و اتخذوه أصل كتابهم، و بقي الكتاب العربي حتى خص اللّه به إسماعيل- عليه السلام- فأصابه، و أما ما ورد من خط إدريس- عليه السلام- فقيل: المراد خط الرمل.
و أول من تكلم بالعربية إسماعيل بن إبراهيم الخليل- عليهما السلام- إلهاما من اللّه- تعالى- قاله صاحب نظم الدرر في فضل سيد البشر.
و اختلف في أول من كتب الخط العربي فقيل آدم، و هو ما تقدم عن كعب الأحبار. و قيل هود.
ذكر ابن هشام في كتاب التيجان عن وهب: أن اللّه- تعالى- أنزل على هود عليه السلام هذه الأحرف (أ ب ت ث) إلى الياء تسعة و عشرين حرفا لفضل اللسان العربي على العجمي و السرياني و العبراني، و أنزل عليه: يا هود إن اللّه آثرك و ذريتك بسيد الكلام، و به يكون لكم استطالة و فضيلة على جميع العباد، حتى يختم اللّه نبوته بمحمد صلى الله عليه و سلم.
و قيل إسماعيل- عليه السلام-، و إن حروفه كلها متصلة حتى الألف و الراء بعكس الحميرية إلى أن فصلها من بعضها ولداه قيدر و الهميسع.
قال ابن عبد البر: عن النبي صلى الله عليه و سلم: «أول من كتب- أي الكتاب العربي- إسماعيل عليه السلام»، و جاء نحوه عن ابن عباس. اه
ص: 231
و قيل: حمير بن سبأ علمه مناما.
و قيل: ثمانية رجال و هم ملوك مدين أسماؤهم أبجد ... إلخ.
روي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه: أن أول من كتب بالعربية قوم من الأوائل أسماؤهم: أبجد و هوز و حطي و كلمن و سعفص و قرشت إلخ، و كانوا ملوكا. اه و هذا القول إنما يجري على القول بأن هذه الكلمات أسماء للملوك، لأن فيها عند أهل العلم ثلاثة أقوال: هي أسماء للملوك، أو أسماء للحروف، أو أسماء للشياطين، و قال الحلبي في السيرة: الصحيح أن أول من كتب بالعربية من ولد إسماعيل- عليه السلام-: نزار بن معد بن عدنان.
و قيل: رجل اسمه مرامر من أهل الأنبار. قاله أبو محمد بن قتيبة في كتاب المعارف.
و قيل: ثلاثة رجال: مرامر بن مرة، و أسلم بن سدرة، و عامر بن جدرة، فمرامر وضع الصدر، و أسلم وضع الوصل و الفصل، و عامر وضع الإعجام.
و هذا القول حكاه المقري.
و ذكر الحافظ أبو عمرو الداني بسنده إلى زياد بن أنعم، قال: قلت لعبد اللّه بن عياض: معاشر قريش هل كنتم تكتبون في الجاهلية بهذا الكتاب العربي تجمعون فيه ما اجتمع و تفرقون فيه ما افترق هجاء بالألف و اللام و الميم و الشكل و القطع و ما يكتب به اليوم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه و سلم؟ قال: نعم.
قلت: فمن علمكم الكتابة؟ قال: حرب بن أمية. قلت: فمن علم حرب بن أمية؟ قال: عبد اللّه بن جدعان. قلت: فمن علم عبد اللّه بن جدعان؟ قال: أهل الأنبار. قلت: فمن أهل الأنبار؟ قال: طارئ طرأ عليهم من أهل اليمن من كندة. قلت: فمن علم ذلك الطارئ؟ قال: الخلجان بن الموهم كاتب هود نبي اللّه- عليه السلام- بالوحي عن اللّه- عز و جل-. ا ه و ذكر الجعبري بسنده إلى الشعبي، قال: سألنا المهاجرين من أين
ص: 232
تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة، و سألناهم: من أين تعلموها؟ قالوا: من أهل الأنبار.
و قال أبو بكر بن أبي داود: عن علي بن حرب عن هشام بن محمد بن السائب قال: تعلم بشر بن عبد الملك الكتابة من أهل الأنبار، و خرج إلى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية.
قال: و قال غير علي: علم بشر سفيان بن حرب الخط، و علم حرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه و جماعة من قريش، و تعلم معاوية من عمه سفيان. ا ه ثم قال: و الخط الذي علمه حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف قريشا هو الخط الكوفي، ثم استنبط منه نوع نسب إلى ابن مقلة، ثم آخر نسب إلى علي بن البواب و عليه استقر رأي الكتاب. اه و قال السيوطي في المزهر: و المشهور عند أهل العلم ما رواه ابن الكلبي عن عوانة، قال: أول من كتب بخطنا هذا- و هو الجزم- مرامر بن مرة و أسلم ابن سدرة أي و كذا عامر بن جدرة و هم من عرب طيئ تعلموه من كاتب الوحي لسيدنا هود- عليه السلام-، ثم علموه أهل الأنبار، و منهم انتشرت الكتابة في العراق: الحيرة و غيرها، فتعلمها بشر بن عبد الملك أخو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل، و كان له صحبة بحرب بن أمية لتجارته عندهم في بلاد العراق، فتعلم حرب منه الكتابة ثم سافر معه بشر إلى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب أخت أبي سفيان فتعلم منه جماعة من أهل مكة، فبهذا كثر من يكتب بمكة من قريش قبيل الإسلام، و لذلك قال رجل كندي من أهل دومة الجندل يمن على قريش بذلك:
لا تجحدوا نعماء بشر عليكم ***فقد كان ميمون النقيبة ازهرا
أتاكم بخط الجزم حتى حفظتموا ***من المال ما قد كان شتى مبعثرا
و اتقنتموها كان بالمال مهملا ***و طامنتمو ما كان منه مبقرا
فجريتم الأقلام عودا و بدأه ***و ضاهيتموا كتاب كسرى و قيصرا
ص: 233
و أغنيتموه عن مسند الحي حمير و ما زبرت في الصحف أقلام حميرا
و إنما قال: أتاكم بخط الجزم، كما قال عوانة: بخطنا هذا و هو الجزم، لأن الكوفي كان قبل وجود الكوفي يسمى الجزم، لكونه جزم أي اقتطع و ولد من المسند الحميري كما في الاقتضاب شرح البطليوسي على أدب الكاتب.
و الذي اقتطعته مرامر و صاحباه علي ما مرّ عن المزهر، و قال السيوطي أيضا في المزهر: و كان ممن اشتهر بالكتابة من عظماء الصحابة الفاروق عمر و عثمان و علي و طلحة و أبو عبيدة من المهاجرين و أبي بن كعب و زيد بن ثابت من الأنصار. اه و أما المدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة و أزكى السلام فلم تكثر الكتابة العربية فيها إلا بعد الهجرة بأكثر من سنة.
و ذلك أنه لما أسرت الأنصار سبعين رجلا من صناديد قريش و غيرهم في غزوة بدر السنة الثانية من الهجرة جعلوا على كل واحد من الأسرى فداء من المال، و على كل من عجز عن الافتداء بالمال أن يعلم الكتابة لعشرة من صبيان المدينة فلا يطلقونه إلا بعد تعليمهم.
فبذلك كثرت فيها الكتابة و صارت تنتشر في كل ناحية فتحها الإسلام في حياته عليه الصلاة و السلام و بعده كما في السيرة.
و الذين كتبوا من الصحابة كانوا الغاية القصوى في الحذق بالهجاء.
و قد أخطأ من قال: لم تكن العرب أهل كتابة ففي هجائهم ضعف و قوله صلى الله عليه و سلم: «إنا أمة أمية لا نكتب و لا نحسب» إخبار عن المبدأ و الغالب.
فائدتان:
الأولى:
كان النبي صلى الله عليه و سلم أميّا لكن لا بالمعنى الشرعي بل بالمعنى اللغوي و هو الذي لا يكتب و لا يقرأ المكتوب قال- تعالى-: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ، و قال- تعالى- أيضا: وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، و قال صلى الله عليه و سلم: «نحن أمية أمية لا نكتب و لا نحسب»
ص: 234
و كان ذلك معجزة له و كمالا في حقه و إن كان نقصا في حق غيره، قال البوصيري- رحمه اللّه-:
كفاك بالعلم في الأمن معجزة*** في الجاهلية و التأديب في اليتم
و إنما لم يكتب بيده الشريفة صلى الله عليه و سلم، قيل: لأنه بعث لتبييض السواد لا لتسويد البياض.
و قيل: لأن القلم عكاز القاضي الذي لا يحفظ شيئا، كما أن العود عكاز الأعمى الذي لا يبصر شيئا.
و قيل: لئلا يدخل خطه إذا وقع في يده من لا يعرف قدره.
و قيل: لئلا يظن أنه مصنف القرآن، و هذا أوجه الأقوال، قال- تعالى- وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ و قيل غير ذلك.
الثانية:
روي عن ابن عباس- رضي اللّه عنهما- أن الخط توفيقي لقوله- تعالى-: عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ و قوله- تعالى- أيضا: ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ.
و في الحكم بسنده إلى عبد اللّه بن سعيد قال: بلغنا أنه لما عرضت حروف المعجم على الرحمن تبارك اسمه و تعالى جده، و هي تسعة و عشرون حرفا تواضع الألف من بينها فشكر اللّه له تواضعه فجعلوه قائما أمام كل اسم من أسمائه- تعالى-.
قال الجعبري: و القياس أن يكون لكل حرف منها شكل لكن تركوا بينها على حد المشتركات فرجعت إلى سبعة عشر شكلا يأتلف وصله و يختلف و انقسمت إلى عديم النظير و ما له نظير واحد و متعدد، فاحتاجت إلى تمييز، و النقط أقله.
فالمتوحد مستغن عن النقط بنصه، و الذي له نظير واحد يميز بنقطة.
و المتعدد يميز بتعدد النقط إلى أقل الجمع.
فالمنقوط يسمى معجما- أي مزال العجمة- و كذا المهمل أيضا لأن
ص: 235
ترك العلامة في المنحصر علامة. اه ببعض اختصار.
قال في فتح الرحمن بشرح مورد الظمآن: و تحقيق ذلك أن للشي ء وجودا في الأعيان و وجودا في الأذهان و وجودا في العبارة و وجودا في الكتابة، فالكتابة تدل على العبارة و هي على ما في الأذهان و هي على ما في الأعيان، و إذا كان الخط دليلا على العبارة و هي منحصرة في تسعة و عشرين حرفا اقتضت الدلالة أن يكون لكل حرف منها شكل يخصه، و لا مدخل للام ألف إذ هو حرف تركيبي لكن أهملت الهمزة من الشكل لكثرة خروجها عن حالها إما بالإبدال المحض و إما بالامتزاج و إما بالحذف فاستغني عنها بما تئول إليه في التخفيف، و أهملوا المحذوفة فيه، و رسموا المبتدأة ألفا و إلى ذلك أشار ابن معطي- رحمه اللّه تعالى- بقوله:
و كتبوا الهمز على التخفيف*** و أولا بالألف المعروف
ثم ترك في بعض الصور حرفان و في بعض ثلاثة و في بعض خمسة.
فالأول: أشكال حروف (سطر فصدع) و نظائرها المعجمات.
و الثاني: شكل الجيم و تالييه- أي الحاء و الخاء-.
و الثالث: شكل حروف (ثبتني) فانتقض بالتشريك في الأول سبعة لأجل تمييزها بالإعجام و هي: الشين و الظاء و الزاي و القاف و الضاد و الذال و الغين، و في الثاني اثنان و في الثالث أربعة تبقى صورة واحدة.
و سلم من الاشتراك ستة و هي حروف: (كل ما هو) إذ لا نظير لها فرجع العدد إلى خمسة عشر، فالمتوحد غني عن النقط، و المشترك محتاج إلى ما يميز أحد المشتركين أو المشتركات.
و أقل ما يقع به التمييز نقطة فزيدت في أحد المشتركين فرقا بينه و بين الآخر، لكن خولف ذلك في الشين فزيد في أعلاه ثلاث مناسبة لشكله، و في الفاء و القاف فنقطا معا أولهما عند أهل المغرب واحدة من أسفل، و ثانيهما من أعلى، و عند أهل المشرق أولهما واحدة من فوق، و ثانيهما اثنتان كذلك،
ص: 236
و زيدت في أحد المشتركات الثلاث من أسفل، و في الآخر من فوق و عري الثالث.
و زيدت في أحد المشتركات الخمسة من أسفل و في الآخر من فوق، ثم زيدت على الواحدة في الثالثة أخرى من فوق و في الرابع أخرى من أسفل، و في الخامس ثالثة من فوق و لم يكتفوا بالتعرية في حرف من هذا الشكل لصغره و كثرة المشتركات، فاحتيج إلى مزيد تمييز، و كل هذه الأشكال توصل بما قبلها و هي في وصلها بما بعدها و فصلها عنه قسمان: مفصول و هي حروف (ذوازرد) و موصول، و هو قسمان: مؤتلف أي متفق الوصل و الفصل و هي حروف (كتب فظ تبط). و مختلفهما و هو الباقي أربعة عشر حرفا و هي:
(ج ح خ ل م ن ص ض ع غ ق س ش ه) ثم إن عرض في الفصل البيان باختصاص الصورة المتطرفة بالحرف و ذلك في حروف (لينفق) فوجهان:
النقط و عدمه، و عليه اقتصر في المحكم و قال في الدرة:
و جملة المنقوط في ***عشر و خمس بعد في
إن وصلت فانقط ***و اتركه إن ما بعيد تفرق
ثم استعير شكل الياء لمهمل و هو الهمزة أهمل من النقط.
قال الجعبري: إلا أن يقصد البدل. اه قال في فتح المنان: و معناه- و اللّه أعلم- ما قاله المرادي عند قول ابن مالك: «و في فاعل ما أعل عينا ذا اقتفى»، أن صورة الهمزة لا تنقط إلا حيث يكون قياس تخفيفهما البدل كما إذا انفتحت بعد كسرة فإنها إذا كتبت على نية الإبدال نقطت. اه و قال في كشف الغمام ما حاصله: أن مذهب القراء نقط الياء التي هي صورة للهمزة، و للنحاة في عدم نقطها مطلقا أو إلا أن ينوي بها البدل قولان، فالمجموع ثلاثة أقوال و أظهرها النقط، لأنها ما لم تنقط مزاحة لمشاركتها في الصورة ... إلى أن قال: و الظاهر أن الياء العوض من الألف و المزيدة كذلك
ص: 237
لما تقدم. اه قال في روضة البستان: و الذي جرى به العمل النقط في الياء مطلقا ما لم تكن طرفا سواء أ كانت مزيدة أو عوضا من الألف أو أصلية. اه ثم المنقوط من هذه الحروف يسمى معجما كما تقدم، ففي القاموس:
أعجم الكتاب نقطه كعجمة و عجمة. و قول الجوهري: لا تقل عجمت، و هم، و حروف المعجم أي الإعجام مصدر كالمدخل أي من شأنه أن يعجم.
ا ه و في المختار: العجم: النقط بالسواد كالتاء عليها نقطتان، يقال: أعجم الحرف و عجّمه أيضا تعجيما، و لا يقال عجمه و منه حروف المعجم، و هي الحروف المقطعة التي يختص أكثرها بالنقط من بين سائر حروف الأمم.
و معناه حروف الخط المعجم كقولهم: مسجد الجامع و صلاة الأولى، أي مسجد اليوم الجامع و صلاة الساعة الأولى، و ناس يجعلون المعجم بمعنى الإعجام مصدرا مثل المخرج و المدخل، أي من شأن هذه الحروف أن تعجم، و أعجم الكتاب ضد أعربه. اه و قوله: النقط بالسواد أي بحسب الأصل و الغالب.
و إلا فقد يكون بغيره إذا كتب به، و هذا النقط هو الدال على ذات الحرف و يقال بالاشتراك على النقط الدال على عوارضه من حركة و سكون، و الدال على ذات الحرف هو نقط الإعجام، و الدال على عوارضه من حركة و سكون، و الدال على ذات الحرف، و الدال على عوارضه هو نقط الإعراب و نحوه و الحرف لفظ مشترك. قال في المختار: حرف كل شي ء طرفه و شفيره وحده، و الحرف واحد حروف التهجي. اه و في المصباح: و حرف المعجم يجمع على حروف.
قال الفراء و ابن السكيت: و جميعها مؤنثة و لم يسمع التذكير في شي ء منها و يجوز تذكيرها في الشعر، و قال ابن الأنباري: التأنيث في حروف المعجم عندي على معنى الكلمة، و التذكير على معنى الحرف.
ص: 238
و قال البارع: الحروف مؤنثة إلا أن تجعلها اسما فعلى هذا يجوز أن يقال هذا جيم و هذه جيم و ما أشبهه. اه
تنبيه:
علم مما تقدم منع كتابة القرآن الكريم بالخط العربي على خلاف الرسم العثماني، فمنع كتابته بغير الخط العربي من باب أولى، و كذا تمنع قراءته بغير اللسان العربي لقوله تعالى: بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ و في الإتقان للجلال السيوطي بعد نقله كلام الجويني في تقسيم المنزل إلى قسمين: ما نزل جبريل بمعناه، و ما نزل جبريل بلفظه ما نصه:
قلت: القرآن هو القسم الثاني و القسم الأول هو السنة، كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة، كما ينزل بالقرآن.
و من هنا جاز رواية السنة بالمعنى لأن جبريل أدّاه بالمعنى، و لم تجز القراءة بالمعنى لأن جبريل أدّاه باللفظ، و لم يبح له إيحاءه بالمعنى، و السر في ذلك أن المقصود منه التعبد بلفظه و الإعجاز به، فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه؛ لأن تحت كل حرف منه معاني لا يحاط بها كثرة، فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه، و التخفيف على الأمة حيث جعل المنزل إليهم على قسمين: قسم يروونه بلفظه الموحى به، و قسم يروونه بالمعنى و لو جعل كله مما يروى باللفظ لشق، أو بالمعنى لم يؤمن التبديل و التحريف فتأمل. اه و أيضا القرآن إنما هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه الذي صح سنده، و وافق العربية، و احتمله رسم المصاحف العثمانية، قال المحقق ابن الجزري في طيبته:
فكل ما وافق وجه نحو*** و كان للرسم احتمالا يحوي
و صح إسنادا هو القرآن*** فهذه الثلاثة الأركان
و حينما يختل ركن أثبت ***شذوذه لو أنه في السبعة
فلا يسمى قرآنا إلا ما اجتمعت فيه هذه الأركان الثلاثة.
ص: 239
اللهم أحسن ختامنا، و اجعل القرآن إمامنا، و اجعله حجة لنا و لا تجعله حجة علينا، و ارزقنا العمل بمقتضاه و تلاوته على الوجه الذي ترضاه، و انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا، و ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين و صلى اللّه على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم.
ص: 240
المراجع و المصادر
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للشيخ الدمياطي- ط عبد الحميد الحنفي.
تقريب النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، ط القاهرة- مصطفى البابي الحلبي.
التيسير في القراءات السبع تأليف أبي عمرو الداني- ط بغداد مكتبة المثنى.
الحجة في علل القراءات تأليف أبي علي الفارسي، ط القاهرة 1965 م.
الحجة في القراءات السبع (المنسوب إلى ابن خالويه)، تأليف د: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت.
الكشف عن وجوه القراءات السبع، تأليف مكي بن أبي طالب القيسي ط بدمشق 1394 ه، 1974 م.
معاني القرآن، للفراء، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب 1955 1972.
معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف و الابتداء، تأليف الشيخ محمود الحصري، طبعة شركة و مطابع الشمرلي بالقاهرة.
إدغام القراء، تأليف أبي سعيد السيرافي ت 368 ه تحقيق دكتور/ محمد على عبد الكريم الرديني، مطبعة الأمانة بشبرا مصر.
السبعة في القراءات، لابن مجاهد، تحقيق دكتور شوقي ضيف، طبعة القاهرة 1972.
الأصوات اللغوية، دكتور/ إبراهيم أنيس، مطبعة الأنجلو المصرية.
الأصوات في قراءة أبي عمرو، للدكتور/ عبد الصبور شاهين رسالة ماجستير، القاهرة دار العلوم 1962 م- 1381 ه.
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي،
ص: 241
القاهرة 1945 م.
تفسير القرطبي لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (التفسير المسمى بالجامع لأحكام القرآن- طبعة دار الحديث بالقاهرة).
غاية المريد في علم التجويد، تأليف الأستاذ/ عطية قابل نصر، طبعة دار الحرمين للطباعة بالقاهرة.
عمدة المجيد (فتح المجيد شرح كتاب العميد) تأليف الأستاذ/ محمود على بسة، طبعة المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة.
مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار، تأليف الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444 ه) تحقيق/ أحمد محمود عبد السميع أبو سنادة المسمى بدر أبو ماضي الموسى، طبعة دار الكتب العلمية- بيروت.
المستنير في تخريج القراءات المتواترة، تأليف دكتور/ محمد سالم محيسن، مطبعة القاهرة.
المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني، المتوفى 381 ه، ط مؤسسة علوم القرآن بيروت.
الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي، تأليف بدر أبو ماضي عبد السميع، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
التبيان في آداب حملة القرآن تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي، طبعة دار الدعوة للطبع و النشر بالقاهرة.
منجد المقرئين و مرشد الطالبين، لابن الجزري المتوفى سنة 833 ه تحقيق دكتور عبد الحي الفرماوي، دار المطبوعات الدولية 1977 م.
فصل الخطاب في سلامة القرآن الكريم، تأليف دكتور/ أحمد السيد الكومي، دكتور محمد أحمد يوسف القاسم، طبعة ثانية عيسى الحلبي، 1974 م.
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، للآلوسي المتوفى سنة 1217 ه، طبعة مصورة عن طبعة دار التراث.
ص: 242
المقنع في رسم مصاحف الأمصار، لأبي عمرو الداني المتوفي سنة (444 ه) تحقيق: أوتو برتزل، مطبعة الدولة استانبول 1932 م.
قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله، للأستاذ جلال العالم، طبعة دار الاعتصام.
الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم و سوره، للدكتور/ محمد أحمد يوسف القاسم، الأولى 1399 ه 1979 م.
عون الرحمن في حفظ القرآن، تأليف: أبي ذر القلموني، طبعة دار العلوم العربية، خلف الجامع الأزهر بالقاهرة.
ففروا إلى اللّه، تأليف أبي ذر القلموني، طبعة دار العلوم العربية بالقاهرة.
بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة، للسيوطي، تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، طبع عيسى الحلبي 1964 م.
تفسير القرآن العظيم، تأليف الحافظ ابن كثير، دار إحياء الكتب العربية القاهرة.
البحر المحيط، تأليف أبي حيان الأندلسي، مطبعة السعادة، القاهرة 1328 ه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، للإمام أبي محمد عبد اللّه جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد اللّه بن هشام الأنصاري المتوفى سنة 761 ه تحقيق عبد المتعال الصعيدي، طبع سنة 1402 ه- 1982 م، دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان.
معاني الحروف، تأليف أبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي المتوفى سنة 384 ه. تحقيق د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي، الطبعة الثانية 1401 ه- 1981 م، دار الشروق للنشر و التوزيع- جدة- السعودية.
ص: 243
فهرس التجديد
الموضوع الصفحة المقدمة. 5
وجوب علم التجويد، و أهمية التلقي من أفواه المشايخ. 10
مسائل ظن البعض أنها نوع واحد. 14
موجز عن تاريخ التجويد و القراءات. 21
القراءات المتواترة. 26
الأحرف السبعة 31 الحكمة من إنزال القرآن الكريم بالأحرف السبعة. 34
صلة القراءات السبع بالأحرف السبعة. 34
آداب حامل القرآن. 35
فصل في الأمر بتعهد القرآن. 41
في كتابة القرآن و إكرام المصحف. 42
حول شكل المصحف و إعجامه. 47
كيفية حفظ و تثبيت القرآن. 56
كيفية تلاوة القرآن الكريم و ما الواجب على مبتدئ تعلم التجويد أن يتعلمه أولا. 71
نبذة مختصر عن جمع القرآن. 82
تقسيم مخارج الحروف. 91
ترتيب المخارج الخاصة الفرعية حسب ورودها في المخارج العامة. 93
ترتيب المخارج بترتيب حروف المعجم. 94
ألقاب الحروف و عددها عشرة. 98
خلاف العلماء حول عدد المخارج. 100
تقسيم صفات الحروف. 103
ص: 245
تماثل و تقارب و تجانس و تباعد الحروف. 115
حكم المثلين و المتقاربين و المتباعدين. 117
الوقف و الابتداء. 119
أهمية الوقف و الابتداء و فوائدهما و الأصل في ذلك. 119
تعريف الوقف و الوصل و السكت و القطع و محل كل منها. 121
أقسام الوقف في ذاته و تعريف كل منها و وجه تسميته باسمه و حكمه. 122
أقسام الوقف الاختياري 123 تعريف الوقف التام و وجه تسميته تامّا و صوره و حكمه. 123
تعريف الوقف الكافي و وجه تسميته كافيا و صوره و حكمه. 124
تعريف الوقف الحسن و وجه تسميته حسنا و صوره و حكمه. 125
تعريف الوقف القبيح و وجه تسميته قبيحا و صوره و حكمه. 127
فوائد تتعلق بالوقف و الابتداء. 128
بعض ما يصح الابتداء به و الوقف على ما قبله و ما لا يصح. 128
أنواع أخرى من الوقف. 128
ص: 246
فهرس الكواكب
الموضوع الصفحة خطبة الكتاب 135 الباب الأول: في الكلام على حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»، و فيه ثمانية فصول: 137 الفصل الأول: في بيان طرقه. 137
الفصل الثاني: في بيان المراد بالأحرف السبعة. 141
الفصل الثالث: في ترجيح أن المراد بالأحرف أوجه من اللغات. 143
الفصل الرابع: في بيان سبب ورود القرآن على سبعة أحرف. 144
الفصل الخامس: في بيان أن اختلاف الأحرف السبعة اختلاف تنوع و تغاير لا اختلاف تضاد و تناقض. 146
الفصل السادس: في بيان فوائد اختلاف القراءات. 150
الفصل السابع: في بيان ما يعتمد عليه في نقل القرآن و أنه جمع كله في حياة النبي صلى الله عليه و سلم. 155
الفصل الثامن: في بيان من جمع القرآن من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه و سلم. 157
الباب الثاني: في الكلام على سبب جمع القرآن و من جمعه و فيه فصلان: 160 الفصل الأول: في بيان سبب الجمع و أن زيدا جمع القرآن كله بجميع وجوه قراءته في زمن أبي أبي بكر رضي اللّه عنهما. 160
الفصل الثاني: في بيان من وضعت عنده الصحف التي جمع زيد فيها القرآن زمن أبي بكر رضي الله عنه و سبب جمع القرآن من تلك الصحف في المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه و من جمعه. 167
الباب الثالث: في الكلام على المصاحف العثمانية و فيه خمسة فصول: 171 الفصل الأول: في بيان ما اشتملت عليه المصاحف من القراءات. 171
الفصل الثاني: في بيان ما فعله عثمان بالمصاحف التي كتبت في زمنه و بالصحف التي كتبت في زمن أبي بكر رضي اللّه عنهما. 174
ص: 247
الفصل الثالث: في بيان حكم تحريق المصحف. 176
الفصل الرابع: في بيان عدد المصاحف العثمانية. 177
الفصل الخامس: في بيان الفرق بين المصاحف و الصحف و بين جمع أبي بكر و جمع عثمان رضي اللّه عنهما. 178
الباب الرابع: في الكلام على ما يجوز من القراءات و ما لا يجوز و فيه ثلاثة فصول: 180 الفصل الأول: في بيان ضابط ما يسمى قرآنا. 180
الفصل الثاني: هل يكفي في ثبوت القراءة صحة السند أو لا بد من التواتر. 184
الفصل الثالث: في بيان حكم القراءة بالقياس و حكم التلفيق في القراءة و تقسيم القراءات إلى ستة أنواع. 187
الباب الخامس: في الكلام على حكم اتباع رسم المصاحف العثمانية و فيه فصول و تنبيهات و تتمة و فائدة مهمة. 190
فصل: في ذكر أدلة وجوب اتباع رسم المصحف العثماني. 191
تنبيهات: 196 الأول: في ذكر بعض فوائد الرسم العثماني و بعض مضار مخالفته. 196
التنبيه الثاني: في بيان أن رسم القرآن توفيقي. 198
تتمة: في بيان بطلان ما ادعاه الملحدة من التغيير أو التحريف في القرآن. 202
فائدة مهمة و خاتمة. 206
ذكر بعض القراءات الموافقة لخط المصحف و ليست من القراءات السبع المشهورة 221
الخاتمة 225
المراجع و المصادر 241
فهرس موضوعات التجديد 245
فهرس موضوعات الكواكب 247
ص: 248