الصورة

ص: 20
مرکز تراث سامراء
الكتاب: سامراء في مجلة سومر الجزء الثاني.
إعداد ونشر : مركز تراث سامراء.
المطبعة: دار الكفيل .
الطبعة: الأولى.
عدد النسخ: 1000 نسخة.
سنة الطباعة: 1441ه_ / 2020م
رقم الإصدار : 19 .
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد
ISBN :
جميع الحقوق محفوظة لمركز تراث سامراء
ص: 1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مرکز تراث سامراء
الكتاب: سامراء في مجلة سومر الجزء الثاني.
إعداد ونشر : مركز تراث سامراء.
المطبعة: دار الكفيل .
الطبعة: الأولى.
عدد النسخ: 1000 نسخة.
سنة الطباعة: 1441ه_ / 2020م
رقم الإصدار : 19 .
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد
ISBN :
جميع الحقوق محفوظة لمركز تراث سامراء
ص: 2
دِيوَانَ الوَقْفِ الشّیعَي
العَتَبَةُ العَسْكرِيَّة المُقَدَّسَةَ
مَركَز تُراث سَامَرَّاء
سَامَرَّاء
في مَجَلَّةِ سُوْمَ
الجُزءُ الثانِي
إعْدَادُ
مَركَز تُراث سَامَرَّاء
ص: 3
ص: 4
مُقَدَّمَةُ المَرْکَز
ص: 5
ص: 6
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين
مما لا شك فيه أن الأمم تحيا وتتطور بتراثها وبحضارتها وبنتاجها العلمي وباعتزازها بعلمائها، وإذا بحثنا عن التراث والحضارة والعلم والعلماء نجد لمدينة سامراء المقدسة نصيباً وافراً منها.
وفي ما نكتبه من سطور في مقدمة هذا السفر، الذي يحمل في طياته عدداً من البحوث العلمية ذات الصلة بتراث وآثار مدينة سامراء المشرّفة، نود أن نركز على أهمية توظيف التراث لبناء المجتمع؛ إذ ليس غريباً أنْ تكون عاصمة الدولة في أي مكان سبباً لازدهاره وتطوره، فيكون محط أنظار العالم، ويكثر فيه العمران والأبنية التي تصبح فيما بعد إرثاً قيماً، لكن العواصم إنما يخلّدها التأريخ، وتحيا في ذاكرة الأجيال عندما تكون مصدراً للعلم والمعرفة، ومصدراً لبناء الإنسان؛ إذ لم تُعرف أثينا عاصمة اليونان بأنها مدينة تاريخية وكفى؛ بل عُرِفت بمفكريها وفلاسفتها مثل أفلاطون وسقراط وأرسطو ونتاجهم العلمي في المنطق والفلسفة.
إِنَّ مَدينة سامرّاء المشرّفة لم تكن عاصمة فحسب، بل أصبحت مصدراً للعلمِ والمعرفة منذ أنّ وطأت قدم الإمام الهادي علیه السّلام أرضها، واستمرت كذلك في زمن الإمام العسكري علیه السّلام والإمام الحجة عجّل الله تعالی فرجه الشّریف و من نزل بها من الأعلام من علماء وأدباء على مرّ تأريخها، وصولا إلى انتقال الحوزة العلمية إليها على يد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه،
ص: 7
وهذا التراث الذي خلّفه هؤلاء الأفذاذ هو ما عبّرت عنه المفاهيم الحديثة بالتراث الثقافي المادي، وغير المادي، وهو ما نصّت عليه معاهدات الأمم المتحدة التي كان العراق طرفًا فيها .
ومن الملفت للنظر أن هذا التراث لم يحظَ بدراسات علمية تحليلية بمعزل عن التأريخ رغم أهميته، حتى نُظهر للعالم أنموذجاً مميزاً من حضارة سامراء وتراثها؛ إذ أن للتراث الثقافي غير المادي أثراً بالغاً في بناء المجتمعات لاسيما التراث الثقافي غير المادي؛ باعتباره جزءًا من عقيدتهم في أغلب الأحيان، مثال ذلك الطقوس الدينية والاجتماعية التي لها الأثر الواضح في بناء السلم الاجتماعي الذي تعد سامراء أنموذجاً رائعاً له ببركة الأئمة علیهم السّلام وحكمة العلماء وتعقلهم، ووعي الجماهير الذي تغلّب على عناصر التطرف حتى انتصر على الإرهاب لتبقى سامراء مثالاً حياً للتعايش السلمي، ومصدراً للفكر المعتدل، ويعد ذلك من أهم نتائج توظيف التراث الثقافي لبناء المجتمع.
وتجدر الإشارة هنا الى أهمية الصيانة الآثارية للمعالم المادية وحمايتها، ولكن لا بدَّ من أن تمتد هذه الصيانة إلى التراث الثقافي غير المادي المتمثل بالطقوس والممارسات الدينية والثقافية والحفاظ على سلامته من الانحرافات الفكرية وحمايته من التطرف للحفاظ على الهوية الإسلامية المعتدلة .
كما نركز على مسألة أخرى لا تقلّ أهمية أهمية التنقيب الآثاري وضرورة الأمانة العلمية في نقل الحقائق التأريخية، إذ تكمن أهمية التنقيب في دقّتهِ، ودوره في حفظ الحقائق، والحفاظ على الآثار والتراث وما لذلك من أثر في حياة الشعوب، والذي قد يؤثر في سلامة البنية الفكرية للمجتمع ولا سيما عندما تؤول نتائج التنقيب إلى اكتشاف أو تحديد أماكن لها علاقة بالجانب الروحي للإنسان.
وفي الوقت الذي نسلط فيه الضوء على فن العمارة الإسلامية وتاريخها،
ص: 8
وصور الإبداع في زخارفها نكون بحاجة إلى تسليط الضوء على أسباب إنشاء تلك المعالم الأثرية، وقراءة أحداثها برؤية موضوعية، فهي إمّا أنْ تكون معلماً دينياً مهماً كالأضرحة المقدسة التي لها الأثر البالغ في بناء الفرد والمجتمع، أو تكون معلماً سياحياً ينعكس أثره على جمالية المدينة، وتنشيط السياحة فيها، أوقد تكون من شواخص الظلم والجور لتظل شاهدةً على التأريخ وعبرةً للأجيال.
ولما تمتلكه مدينة سامراء من ميزات علمية وحضارية وآثارية لا يسع المجال لذكرها نتطلع الى النخبة الذين يرومون المشاركة في نشر تراث هذهِ المدينة المشرّفة، ونيل شرف الكتابة والبحث العلمي الرصين عن تراث أئمتها علیهم السّلام وأعلامها ومعالمها، أنْ يكتبوا في هذا المجال كتباً لتُطبع وبحوثاً لتُنشر بوساطة مركز تراث سامراء التابع للعتبة العسكرية المقدسة، الذي أخذ على عاتقهِ العمل على نشر تراث مدينة سامراء المشرّفة وأئمتها علیهم السّلام وأعلامها من خلال التأليف والتحقيق والبحث وجمع الوثائق وترجمتها بغية إعادة سامراء إلى الذاكرة، بعد أنْ غيّبها التأريخ لقرون خلت؛ لتبقى حاضرة إسلامية خالدة، بتراثها العلمي وآثارها الفريدة.
ولا يخفى ما لمجلة سومر من أهمية كبيرة في مجال الآثار والتراث، وما لبحوثها من قيمة علمية جعلتها محطّ اهتمام الباحثين منذ صدورها في عام (1945م) ، ونظراً لكثرة أعدادها وشحّة وجودها، فقد توجّه مركز تراث سامراء منطلقاً من ضرورة توفير المادة العلمية للباحثين إلى استلال كل ما كتب فيها من بحوث عن مدينة سامراء، وأعدّها في إصدار بجزئين، طبع الجزء الأول عام (2017م)، ونضع الآن بين يدي القارئ الكريم الجزء الثاني بالعنوان نفسه وهو (سامراء في مجلّة سومر) ليضاف إلى رصيد المركز في إصداراته التي بلغت أربعين إصداراً بين تحقيق وتأليف، فضلاً عمّا سيصدر قريباً إن شاء الله من فهارس للمخطوطات وبيبليوغرافيا حول ما كتب عن سامراء وما كتب فيها، والتي تضم بين ثناياها مئات العناوين.
ونود الإشارة إلى أن هذه البحوث نشرت كما هي، وأغلب المعلومات والعبارات
ص: 9
التي تتعلق بالنظام السابق، أو ببعض الحكومات المتعاقبة لا تمثل وجهة نظر المركز، بل تعبر عن رأي الباحث، علماً أن أغلبها قد كُتِبت خلال القرن المنصرم، وقد حصل المركز على موافقة رسمية من الهيئة العامة للآثار والتراث لاستلال البحوث وإعداد هذا الإصدار وطباعته ونشره بالتعاون مع الهيئة.
وفي الختام، لا يسعنا إلّا أنْ نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى جميع الإخوة الأفاضل العاملين في مركز تراث سامراء لجهودهم المتميزة في العمل العلمي خدمةً لمدينة سامراء المشرفة وأئمتها علیهم السّلام وأخص بالذّكر شعبة الدراسات والبحوث وما بذله الأخ الأستاذ محمد حربي من جهد في مراجعة هذا الكتاب، وكذلك كل الإخوة الذين بذلوا جهداً في إعداده بجميع مراحلهِ؛ لأنه في الواقع لا يتم أيُّ منجز علمي إلَّا بجهود جميع العاملين في المركز كلاً حسب تخصصهِ. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة وجميع الإخوة الخدام؛ لدعمهم المتواصل لإنجاح عمل المركز.
سائلين المولى عزّ وجلَّ أنْ يوفق المهتمين بالتراث والباحثين وكادر مركز تراث سامراء وخدام العتبة العسكرية المقدسة لخدمة هذهِ المدينة المشرفة على مشرفيها آلاف التحية والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمد وآل محمد.
مركز تراث سامراء
النجف الأشرف
8/شوال/ 1440ه_
12/ 6 / 2019م
ص: 10
وزارة الثقافة الهيئة العامة للآثار والتراث
Ministry of Culture State Board of Antiquities Heritage
العدد: 7812
التاريخ: 3/6/ 2016
مكتب رئيس الهيئة
الى / العتبة العسكرية المقدسة - مركز تراث سامراء
م / موافقة نشر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
اشارة الى كتابكم ذي ألعدد 37 في 2016/5/29 .
لامانع لدينا من طبع ونشر البحوث الخاصة بسامراء والمستلة من مجلة سومر وبحسب القائمة المرافقة لكتابكم أعلاه في اصدار خاص أو ضمن أصدار شامل لغرض التوثيق ونشر الثقافة عن مدينة سامراء المقدسة شريطة ذكر صيغة هذا في ديباجة الكتاب وبالشكل التالي : (بالتعاون مع الهيئة العامة للاثار والتراث ) .
راجين ذكر المصادر وأعدادها ... مع التقدير
قیس حسین رشید
وكيل الوزارة لشؤون السياحة والاثار / وكالة
4/6/2016
نسخة منه الى /
-مكتب السيد وكيل الوزارة لشؤون السياحة و الاثار وكالة/ للتفضل بالأطلاع ... مع التقدير
-الأضبارة الخاصة .
Email: Chairman_sbah@yahoo.com
ص: 11
ص: 12
المجلد الثالث والعشرون سنة 1967
بقلم: ربيع القيسي
منقب آثار
نبذة تأريخية:
يقع قصر العاشق على الضفة الغربية لنهر دجلة مقابل دار العامة، ويعد من أهم القصور التاريخية الأثرية المتخلفة عن العاصمة العباسية سامراء (انظر المخططة رقم 1). وكان قد سماه المؤرخون بالمعشوق، وقد جاء في معجم الأدباء أن أبا الحسن علي بن المنجم بنى للمعتمد على الله الخليفة العباسي أكثر هذا القصر.
والقصر مستطيل مقاساته 131 متراً من الشمال إلى الجنوب، و 96 متراً من الشرق إلى الغرب، تحيط به مسناة من بعض جهاته لحمايته من مياه الأمطار، وهو متين البناء، إذ إنّ معدل عرض جدرانه الخارجية 2,60 متراً، إضافة إلى أنه معزز بأبراج ضخمة تدعمه من جوانبه المختلفة، وذلك ما حدا بالكتاب والجغرافيين إلى إطلاق صفة القلاع عليه، فمن القدامى مثلاً الرحالة العربي الشهير ابن جبير، ومن المحدثين المستشرق الفرنسي فيوله، والذي كان من أوائل المستشرقين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بهذا الأثر ، فنشر دراسة قصيرة عنه وبعضاً من مخططاته في كتابه الذي طبع في باريس سنة 1911:-
Un Palais Musulman de lxe Siecle
ثم قام المستشرق الألماني هرتسفلد بإجراء تنقيبات قليلة فيه قبيل الحرب
ص: 13
العالمية الأولى ونشرها في كتابه: -
Enster volauflger Bericht uder die Ausgrabungen von Samarra
وأخيراً تولت مديرية الآثار العامة مهمة صيانة هذا القصر وإكمال الحفائر فيه حيث إنها تقوم بهذا العمل منذ عام 1963 ، وسيقتصر بحثي هذا على أعمال الصيانة التي جرت فيه والتي بواسطتها استطاعت مديرية الآثار العامة الحفاظ على البقية الباقية من جدرانه وأبراجه المتداعية، كما أنها تمكنت من تقوية الكثير من جدران مرافقه الداخلية التي استظهرت بنتيجة أعمال الحفائر المستمرة، هذا وقد اضطررنا في بعض الأحيان إلى الارتفاع بالجدران لمسافات قليلة ذلك للحيلولة دون تأثير الرطوبة ومياه الأمطار التي تتجمع في بعض الأماكن، مما قد يكون لها تأثير بالغ وسيء في ما تبقى من الجدران، كما سنوضح ذلك تباعاً فيما يأتي.
الصيانة الأثرية:
نقصد بالصيانة أن نحافظ على المباني الأثرية محافظة تامة بالبناء والترميم دون حذف أو زيادة أو تبديل، وطبقاً لهذا المفهوم العلمي للصيانة قامت مديرية الآثار العامة في العراق - بعد وضع منهج علمي - بصيانة قصر العاشق في سامراء، حيث باشرت أعمالها الفنية صباح يوم 9-8-1963 من هيئة فنية (1) تضم بعض مختصيها في هذا الحقل، وبدأت عملها بتنظيف الجهة الشمالية للقصر، وقد فضلت هذه الجهة قبل غيرها من أجزاء القصر لكونها مشتملة على بقايا جدران يمكن الاهتداء بها في صيانة الأقسام المتهدمة والزائلة من مرافق القصر وإعادة البقايا الزخرفية المتخلفة منها، وقد رفعت الهيئة الأنقاض والأتربة المتراكمة لصف هذا القسم فظهرت بعض معالمها وكانت بحالة
ص: 14
رديئة، وكشف عن طابق أسفل تحت هذه الجهة بهيئة سرداب مشيد بالآجر والجص على غرار الأواوين المألوفة في العمائر الإسلامية، وهدى الكشف الأثري أيضا إلى أن جدار الجهة الشمالية تصاحبه من الخارج مجموعة من الغرف بهيئة مستطيلات متوازية ومتعامدة على هذا الجدار، وقد تم رفع الأنقاض من بعضها وظهر إحداها هي الغرف الشرقية - تكون ممراً يؤدي إلى مرافق القصر العليا، ويحتمل أن يكون هذا الممر مدخلا للقصر من جهته الشمالية، وقد شيد هذا المدخل بالآجر والجص بهيئة سلم منحدر على دفن من الأتربة، ويرتفع هذا البناء إلى مسافة (4) أمتار ثم ينعطف نحو اليسار وبعد مسافة (11) متراً ينحرف مرة أخرى نحو اليسار مشكلاً ممراً يصل الى نقطة تقع فوق باب المدخل وعندها ينتهي الدفن المشيد عليه السلم، وظهرت دلائل معمارية أخر تؤكد استمرار هذا السلم وانعطافه يساراً مرة ثالثة ابتداءً من نقطة انتهاء دفنه، حيث يتصل بعقد مشيد من الخشب مشكلاً سقفاً للسلم الأسفل يؤدي بعد مسافة (11) متراً إلى مدخل عرضه متران يفضي إلى مرافق القصر.
وقد عثر على نوافذ عديدة تتخلل جدران المدخل للإضاءة والتهوية ومازال هذا القسم خاضعاً للبحث الأثري والصيانة، وبعد إتمام عملية إزالة النقض من معظم أجزاء هذه الجبهة بوشر ببناء القسم المتهدم من الجدران بالآجر والجص المصنوع محلياً، فجددت قاعدة برج الركن الشمالي الشرقي بالآجر المائل إلى الصفرة(1)، بينما القسم الدائري من هذا البرج شيد بالآجر المعمول بالجص طبقاً للقسم القديم، ولوحظ أن بعض أجزاء هذه الجبهة بارزة بمقدار قليل عن وضعها الطبيعي نتيجة الضغط الذي أحدثته كميات الأنقاض والأتربة التي تراكمت داخل القصر، لذا ربطت أجزاؤها
ص: 15
وقويت أطرافها مع الجدران الحديثة التي أخذت حد استوائها على الأسس الأصلية، وأصبح الجدار القديم يبرز قليلاً عن البناء المجدد، انظر (الشكل-1). ثم امتدت أعمال الصيانة الأثرية إلى الجزء الغربي من الجهة الشمالية للقصر، فبعد إكمال تنظيف الجدران وإزالة الأنقاض بوشر بالبناء في الأجزاء المتساقطة، فتمت صيانة برج الركن الشمالي الغربي والبرج الذي يليه - باتجاه الشرق - كذلك المنطقة الممتدة بينهما، وهناك أقسام قديمة من الجدران حفظت وأُسندت بالبناء الحديث، كما تم تجديد بقايا المشاكي (1) بما فيها الأبراج الأسطوانية التي تزين هذا القسم من السور على مقاساتها القديمة وأجزائها الأصلية، ذلك ما تم في الموسم الأول عام 1963 - 1964 .
أما في الموسم الثاني عام 1964-1965، فقد باشرت هيئة فنية(2) أخرى وركزت أعمالها في الجهة الشرقية من القصر، وذلك برفع الأتربة والأنقاض والأحجار والحصى الذي كان يغطيها، ثم بوشر بأعمال البناء على طول هذه الجهة، فقويت الأجزاء المتفسخة وشُدت إلى بعضها ورُفعت إلى مسافات متباينة وقد ظهر ما يلي:-
1- بقايا أبراج مستطيلة الشكل ظهرت بصورة متصدّعة، وقد صينت طبقاً لمعالمها الأصلية القديمة بالآجر الكبير (الفرشي) المشابه للآجر المستخدم في بناء معظم أجزاء القصر، وقياسه 10/5 × 5/ 10 × 5 / 2 إنج، انظر (الشكل- 2).
ص: 16
2 - كتل طينية ضخمة مخلوطة بالجص، وأحياناً بالحصى، وجدت لصق الجهة الجنوبية من الجهة المذكورة وتمتد من الزاوية الجنوبية الشرقية للقصر إلى مسافة 55 متراً، أي إلى منتصفها تقريباً ويبلغ معدل سمكها 3 أمتار وارتفاعها عن مستوى الأرض ما بين 2- 4 أمتار، مشيدة باللبن بهيئة دخلات وطلعات مبالغة في تحصين هذا الجانب من القصر؛ لأن جُدر هذا القسم قد تصدعت ومالت إلى الامام بمسافة 40 سم تقريباً نتيجة الضغط الناتج عن جُدر المرافق الداخلية. انظر (الشكل- 2).
3- عثر في منتصف هذه الجبهة على مدخل تدل معالمه البنائية على أنه من المباني المضافة لهذا القسم، وبتعبير أدق متأخر بقليل عن زمن تشييد هذا الجانب، ولوحظ أن لهذا المدخل مسطبة مسيّعة بالجص تبدأ من الركن الشمالي الشرقي وترتفع بمحاذاة جدار الجبهة حتى تصل ممراً منحدراً عرضه 2 متراً يؤدي إلى مرافق القصر، على جانبيه أبنية معقودة بأجر أحمر غير منتظم في شكله يختلف عن الآجر السائد في معظم أبنية القصر، انظر الشكل - 2 ، 3) .
4 - كشف على يسار المدخل المذكور عن ثلاث غرف مستطيلة الشكل مداخلها باتجاه الشرق طولها 11/5 متراً وعرضها 4/5 متراً، ذات جدران سميكة تبلغ 1/5 متراً، مشيدة بهيئة متعامدة لصق جدار هذا الجانب من الجبهة ولا تتصل به اتصالاً بنائياً متداخلاً مما يرجح أنها متأخرة بقليل عن زمن تشييد هذه الجبهة، وقد رفع نقضها ثم صينت بمسافة 2 متراً لتحديد معالمها، انظر (الشكل - 2 ) .
5 - تم الكشف في هذه الجبهة عن ميازيب عمودية منحوتة عرضها 30 سم وعمقها 20 سم لتصريف مياه الأمطار، وقد تبين من البحث الأثري أن هذه الميازيب قد نحتت بعد تشييد جُدر القصر بالضرورة حيث لوحظ آثار قص الآجر ثم تسييعها بالجص، وكان هذا القص يخترق جانباً من المشاكي التي تزين ظاهر الجدران، وقد صينت تلك الميازيب طبقاً لشكلها القديم ونتيجة لهذه الأعمال فقد أصبح القسم واضح المعالم بعض الشيء.
ص: 17
ولم تكتف الهيئة الفنية بصيانة الجبهة الشرقية فقد ركزت أعمالها كذلك في المرافق الداخلية وملحقاتها، فأعيد ما اندثر من بعض جدرانها المزخرفة إلى علو ما بين متر ومترين وسيّعت بالجص منعاً لتسرب مياه الأمطار وعوارض الطبيعة، كما عالجت الهيئة بعض ما اكتشف من نقوش وكتابات في جدران هذا الجانب حيث اهتمت اهتماماً كاملاً قي المحافظة على النص الكتابي المستظهر في جدار الممر الوسطي الذي يؤدي إلى مرافق القصر (انظر المخططة رقم 2).
اما في موسم عام 1965 - 1966 فقد ركز العمل في الجانب الغربي من القصر وكانت الهيئة مؤلفة (1) برئاستنا، حيث تم رفع الأتربة والنقض المتراكم لصق هذا القسم وما حوله، وقد ظهرت هذه الجبهة بحالة رديئة نتيجة الهدم أو تأثير العوارض الجوية. ولوحظ أن الجدران المستظهرة مائلة عن وضعها الطبيعي، مما اضطررنا إلى ترميم وصيانة الركن الجنوبي الغربي وباستقامة جداره إلى الركن الشمالي الغربي، حيث أعيدت هذه الجبهة بالمواد البنائية وقوّيت أطرافها باستقامة إلى ارتفاع يقرب من ستة أمتار كما يلاحظ من الشكل المرقم (5) . ويظهر من ذلك أن ثمة إفريزاً يختم أعلى هذه الجبهة وبعض الميازيب لتصريف مياه الأمطار موضوعة على جانبي الأبراج الوسطية.
ولوحظ كذلك أن ثمة منفذاً طرفه بهيئة عقد يتوسط البرج الرابع والثالث من هذه الجبهة عرضه 2 متراً أعيد إلى وضعه الأصلي بالمواد البنائية كذلك.
وهدى البحث الأثري إلى وجود مرافق بنائية بهيئة غرف صغيرة تقع أمام المدخل المذكور وتصاقب جدار القصر من هذا الجانب وقد أرجئ العمل فيها لقرب انتهاء الموسم، انظر (الشكل -6) .
ص: 18
ثم عاودنا العمل (1) عام 1966 - 1967 فاستكملت الجهة الغربية ، ثم أعقبها تنظيف شامل للجهة الجنوبية من القصر، فاستظهرت بقايا أربعة أبزاج صينت ثلاثة منها ابتداءً من الركن الجنوبي الغربي، وكذلك جدرانها إلى علو يقارب مستوى جدران الجهة الغربية، وظهر من البحث الأثري أن بعض جدران هذه الجبهة قد شيّد مباشرة على وجه الأرض من دون أساس وذلك لصلابة الأرض التي تقوم عليها الجدران، ولوحظ كذلك أن بعض الترميمات قد أجريت على هذا القسم في وقت متأخر عن بناء القصر حيث ظهر آجر يختلف في مقاساته وأشكاله عن الآجر الأصلي المستخدم في هذه الجبهة، ثم ظهر في هذا الجانب مدخل صغير آخر بهيئة عقد على غرار المدخل الموصوف آنفاً في جدار الجبهة الغربية، وقد تمت صيانته وأعيد إلى شكله الأصلي.
وكشف كذلك عن جملة مرافق قرب هذا المدخل على غرار المرافق المصاقبة لمدخل القسم الغربي من القصر، أما في داخل القصر فقد قامت الهيئة باستكمال ما أنجز من أعمال الصيانة في ذلك الجانب حيث تم ترميم بعض الجدران الوسطية وأعيدت إلى شكلها الأصلي بمسافات وارتفاعات تحدد شكل المرافق الداخلية والمؤدية إليها.
وهذا ما قامت به هيئات مديرية الآثار العامة الفنية من أعمال الصيانة في قصر العاشق، علماً بأن أجزاء كبيرة منه ما زالت خاضعة للعمل، وما زالت قيد الدرس.
ص: 19
الصورة

ص: 20
الصورة

ص: 21
الصورة
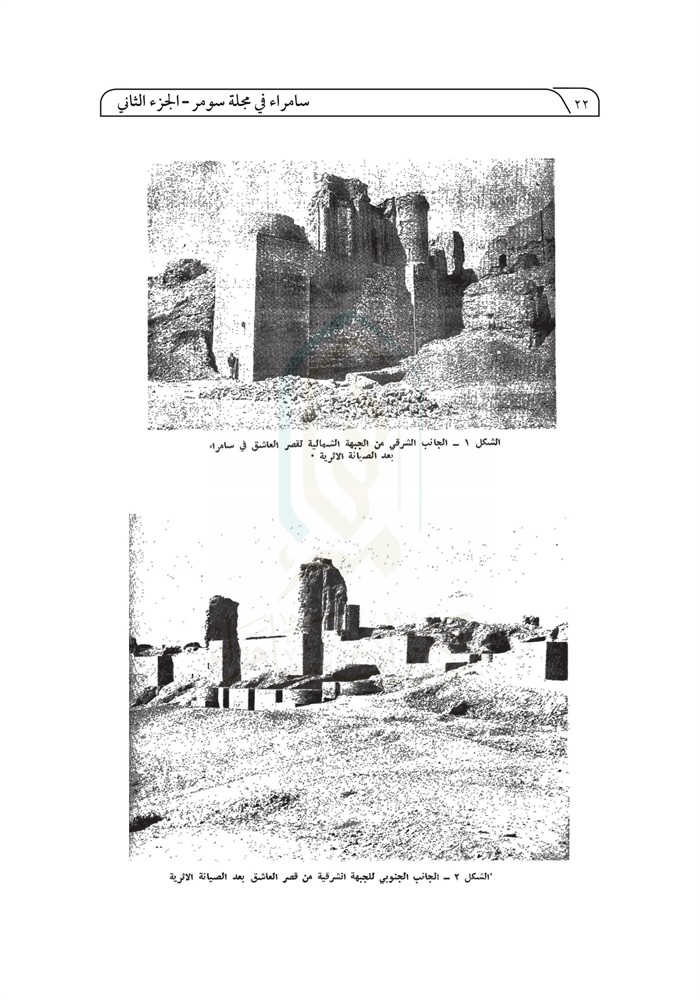
ص: 22
الصورة
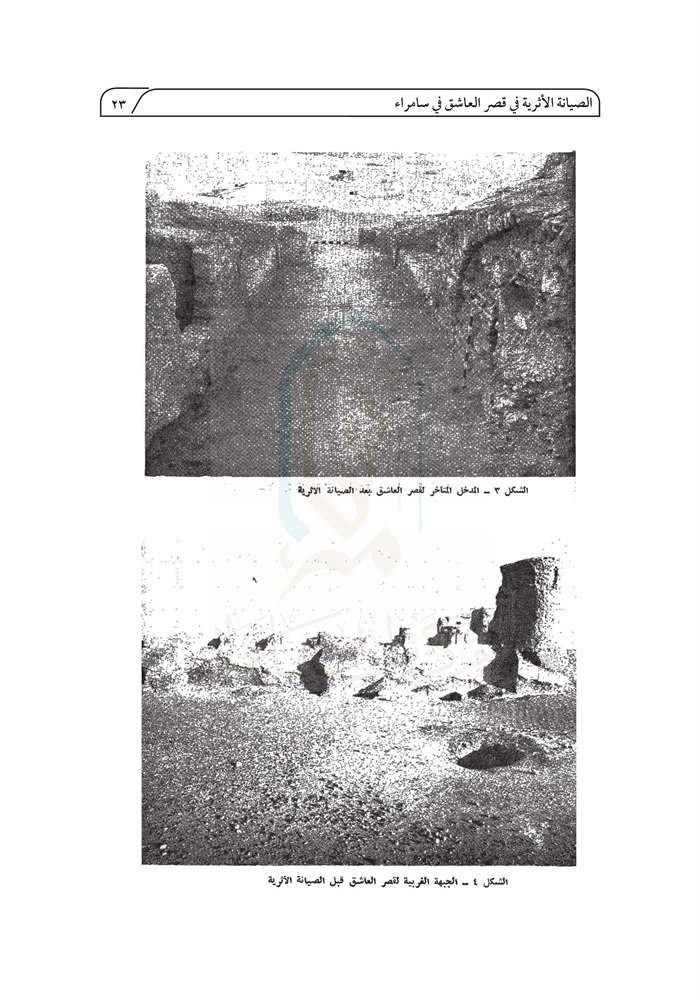
ص: 23
الصورة

ص: 24
الصورة
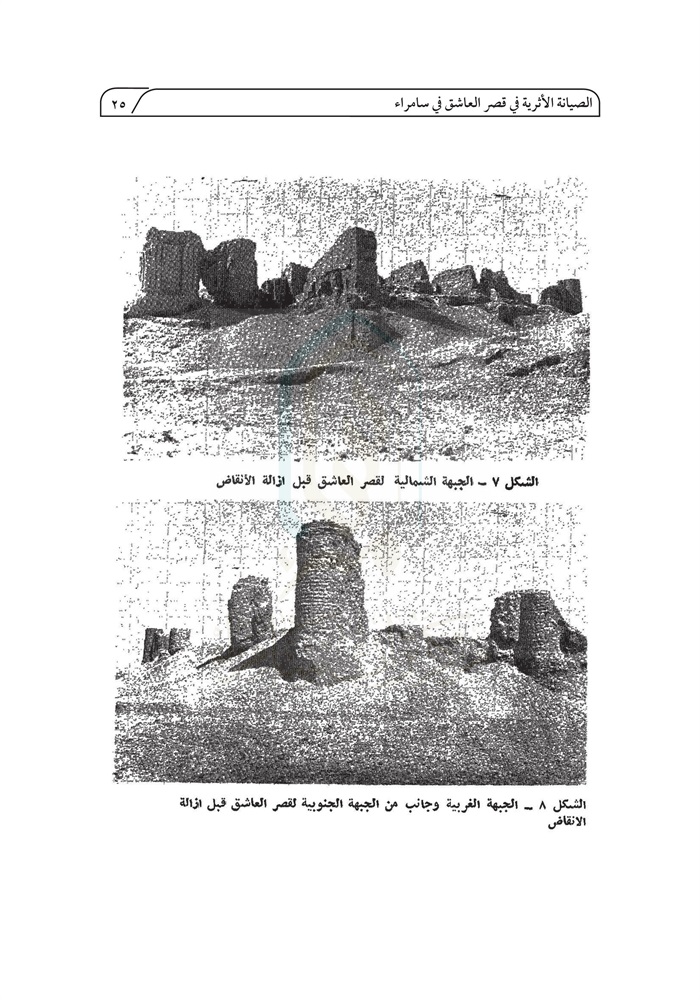
ص: 25
الصورة

ص: 26
المجلد الرابع والثلاثون سنة 1981
بقلم: د. طارق جواد الجنابي
باحث علمي
تمهید:
لا يخفى ما لسرّ من رأى (سامراء) من أهمية خاصة من الوجهة الأثرية بين مدن العراق القديم؛ ذلك لأنها شيدت وازدهرت وهُجرت خلال فترة قصيرة (حوالي نصف قرن)؛ لهذا السبب فإن كل ما فيها من المباني والآثار يعود إلى دور معين وتأريخ معين يمكن تحديده بالقرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي.
ان التراث الحضاري لمدينة سامراء غني جداً وينحصر فيما تخلف عنها من عمائر أثرية وما كشفت وتكشف عنه التنقيبات الأثرية في الوقت الحاضر (1).
كذلك فإن تخطيط المدينة بشكلها الهندسي الرائع ونظام الري القديم فيها يعتبران من أهم المؤشرات الحضارية لهذه المدينة العريقة (انظر الخارطة الشكل1).
أما العمائر الأثرية التي لا تزال بقاياها شامخة فهي ابتداء من الجنوب حصن أو معسكر القادسية، القصر المنثور أو بلكوارا ، وهو القصر الذي سكنه الأمير عبد الله المعتز بن المتوكل، الجامع الكبير في سامراء (الملوية)، سور عيسى، قصر باب العامة أو قصر الخلافة العباسية، وهو القصر الذي بناه وسكنه المعتصم وبعض خلفائه من
ص: 27
بعده. تل العليق أو كما يسمى محلياً (تل العليج)، وساحة الفروسية والصولجان، الشارع الأعظم والشوارع المتصلة به على الجانبين والقصور التي على جانبيه، قطيعة القائد أشناس، جامع وبقايا قصور منطقة الزنكور (1) أو (قصور الحريم)، بقايا مدينة المتوكلية جامع أبي دلف، بقايا القصر الجعفري الذي بناه المتوكل، بقايا قنطرة الرصاصي على نهر القاطول الأعلى التي أمر بإقامتها المتوكل.
ومن الجهة الغربية من نهر دجلة هناك معسكر الإسطبلات، القصر المعشوق أو ما يسمى محلياً بالعاشق وهو القصر الذي أفأمة المعتمد آخز الخلفاء العباسيين الذين سكنوا سامراء، والقبة الصليبية التي أقيمت في زمن المنتصر بن المتوكل ودفن فيها بعض الخلفاء الذين حكموا بعده حسب رأي هر زفلد)، وقصر الحويصلات.
وهناك أيضاً في أقصى الجنوب جسر حربي الذي يعود إلى العصر العباسي الأخير، وهو من بناء المستنصر بالله القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي(2)، وكذلك قبة الإمام محمد أبي الحسن في الدجيل، وهي على الأرجح تعود إلى العصر التيموري، القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي.
أما في اقصى الشمال فلدينا القبة المقرنصة الشهيرة بقبة امام الدور، وهي أقدم القباب المقرنصة في العراق، وتعود إلى القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي. أن هذه العمائر والمواقع الأثرية بالإضافة إلى المراقد الدينية المقدسة مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري (رضي الله عنهما) وقربهما من بغداد يعطيان للمدينة بعداً أثرياً وسياحياً مهماً جداً.
لقد بدأ اهتمام العلماء الأجانب بأطلال مدينة سامراء منذ أواسط القرن التاسع عشر غير أن إقدامهم على التنقيب فيها لم يبدأ إلا بانتهاء العقد الأول من
ص: 28
القرن العشرين، فقد قام المهندس الفرنسي (هنري فيوله) لأول مرة ببعض التنقيبات الاستكشافية في دار الخليفة خلال الصيف سنة 1910 (1) ، ثم أعقبه في السنة التالية العالم الألماني هرز فلد على رأس بعثة علمية وقام بتنقيبات واسعة دامت عدة سنوات، حتى نشوب الحرب العالمية (2).
إن هذه التنقيبات شملت قصر الخليفة ، قصر بلكوارا . القصر المعشوق، الجامع الكبير في سامراء، جامع أبي دلف في المتوكلية، تل العليق مع حوالي خمس عشرة داراً من دور السكنى وتشير مصادرنا إلى أن الآثار التي عثر عليها هرزفلد في خلال هذه التنقيبات كانت قد وضعت في صناديق بقيت في سامراء خلال الحرب العالمية الأولى غير أنها نقلت إلى إنجلترا بعد انهيار القوات العثمانية ودخول الإنجليز (3).
اما النتائج العلمية التي تمخضت عن هذه التنقيبات فقد نشر قسم منها في خمسة مجلدات ضخمة (4)وأما القسم الباقي فلم ينشر إلى الآن. إن المجلدات التي نشرت عن نتائج التنقيبات تبحث في الزخارف والرسوم المائية الملونة على الجص، والمواد الزجاجية والآثار الخزفية، والفخارية. وأما المجلدات التي تتضمن التفاصيل
ص: 29
المعمارية والمخططات فإن قسماً منها لم تطبع إلى الآن(1).
أما التنقيبات العراقية في سامراء، والتي كانت تديرها مديرية الآثار العامة آنذاك، فقد بدأت منذ مطلع ربيع عام 1936 على شكل مواسم كل موسم يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر (انظر الشكل 2) واستمرت حتى عام 1939، وقد انحصر التنقيب خلال هذه المواسم في أربعة مواضع قرب سور المدينة الحالية وقد نشرت النتائج الأولية لهذه التنقيبات عام 1940 بجزأين، الأول يبحث في العمارة والزخرفة، والثاني في الآثار المنقولة كالخزف والزجاج، والرخام والخشب والمعادن (2).
وخلال مواسم هذه التنقيبات جرت أول صيانة أثرية من نوعها في سامراء، وقد شملت الملوية وأبراج وجدران المسجد الجامع ومحرابه وقصر الخليفة وجامع (أبو دلف)، ومئذنته والقصر المعشوق (العاشق).
وفي عام 1940 قامت هيئة عراقية برئاسة المرحوم المهندس محمود العينه جي بأعمال حفر وصيانة واسعة النطاق في جامع أبي دلف (3).
وفي فترة السنوات العشر المحصورة بين 1958 و 1968 تولت العمل في سامراء عدة هيئات عراقية كان من أبرز أعمالها التنقيبية اكتشاف بيت عباسي إلى الغرب من الملوية بمسافة قصيرة مليء بالزخارف الجدارية الجصية أطلق عليه اسم بيت الزخارف (4).
ص: 30
أما بقية النشاطات الآثارية فقد ركزت على صيانة كل من جامع سامراء الكبير والملوية والقصر العاشق والقبة الصليبية بموارد مالية محدودة وعلى شكل مواسم.
أما في الفترة المحصورة بين 1968 ، 1977 فقد كانت النشاطات مركزة على أعمال صيانة جامع سامراء الكبير وملويته، وكذلك رفع الأنقاض من القصر المعشوق (1).
منذ صدور كتاب حفريات سامراء في سنة 1940 وإلى حد الآن لم ينشر أي مطبوع يتناول البحث في نتائج الحفريات التي جرت في سامراء العباسية، هذا إذا استثنينا ما نشره المرحوم العينه جي سنة 1947 حول جامع أبي دلف، من هنا جاءت أهمية نشر بحث يسد مثل هذا الفراغ العلمي.
لقد قامت المؤسسة العامة للآثار والتراث بإيفاد هيئة للتنقيب والصيانة الآثارية في سامراء في شباط 1978 برئاسة كاتب البحث (2). وقد عملت الهيئة في عدة مواقع شملت صيانة جامع (أبي دلف). وإجراء تنقيبات في كل منطقة من سامراء الأثرية في الجهة الغربية من الملوية وفي المتوكلية. وقد أنجزت الهيئة صيانة معظم الجزء الشمالي (مؤخرة الجامع) وبيت الصلاة الواقع في القسم الجنوبي من جامع (أبي دلف) وكانت هذه الأقسام مهددة بخطر الانهيار التام، وكذلك تم كشف بنايتين عباسيتين في المتوكلية إحداهما بالقرب من الشارع الأعظم جنوب شرق جامع أبي دلف، والأخرى إلى الغرب من الجامع المذكور على ضفة نهر دجلة. استمرت
ص: 31
الهيئة حتى نيسان 1981 (1).
هدف هذا البحث هو تسجيل نتائج التنقيبات والصيانة الأثرية التي جرت ما بين شباط 1978 و نیسان 1981 في المواقع التالية وحسب تسلسلها الزمني:
1- سرداب يعود إلى دار عباسية.
2- تنقيبات في المتوكلية لموقع قبة هجول.
3- تنقيبات الموقع المسمى بقبر أبي دلف.
4- تنقيبات حارة سكنية عباسية بالقرب من الملوية.
5- الصيانة والتحري في جامع أبي دلف.
1- سرداب يعود إلى دار عباسية :
في آذار سنة 1978 كشف هذا السرداب عن طريق الصدفة أثناء قيام بلدية سامراء بتنفيذ التسوية الترابية للطريق الثاني الذي يؤدي من سامراء إلى مدينة الدور الواقعة إلى شمالها.
يقع هذا السرداب الذي هو بالأصل جزء من دار عباسية إلى الشمال الغربي من جامع سامراء الكبير على بعد حوالي نصف كيلومتر.
ويبدو أن الدار التي يعود لها هذا السرداب، والذي لا يبعد ألا بعض أمتار عن الركن الجنوبي الغربي لسور عيسى، قد تهدمت في وقت غير معروف لدينا، وبما أن سامراء وأبنيتها العباسية تعود إلى القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) فإن هذا السرداب - والحالة هذه - يعطي فكرة عن تخطيط السراديب العراقية التي كانت سائدة في العمارة العراقية المدنية في ذلك الوقت والتي كانت تستخدم كوسيلة ناجحة
ص: 32
للتخلص من الحر الشديد في فصل الصيف.
قامت هيئتنا أول الأمر بإيقاف عمل البلدية في النقطة التي كشف فيها عن السرداب، بعدها باشرنا التنقيب والتحري عن أجزاء السرداب، وتم لنا رفع كافة الأتربة والأنقاض التي بداخله، وبعد إكمال هذه العملية توضح لنا المخطط الذي نفذ بموجبه السرداب (انظر الشكل 3).
لقد نفذ السرداب عن طريق الحفر في باطن الأرض المتكونة جيولوجياً من مادتي الحصو الناعم والكلس المتحجر وهذه التركيبة تسمى محلياً (الجثان) أو السن. نهبط للسرداب عن طريق سلّم متكون من سبع درجات ثم ننعطف يميناً للمدخل الرئيسي للسرداب الذي يبلغ اتساعه 85 سم ، وهو بشكل عقد نصف دائري خفيف التدبب يبلغ ارتفاعه 1،70 يقود هذا المدخل إلى ممر ضيق يعلوه قبو ذو شكل نصف برميلي يؤدي إلى قاعة ذات قبو نصف برميلي أيضاً قياسها ستة أمتار طولاً 1،85م عرضاً. أما ارتفاع القاعة فيبلغ 1،70 م ، ولها كوة دائرية قطرها 50 سم في وسط سقفها تستخدم بلا شك للإنارة والتهوية.
في وسط هذه القاعة في الجهة الشرقية منها مدخل معقود يبلغ اتساعه متراً واحداً يقودنا عن طريق ممر ضيق صغير مقبى طوله 1،50 م إلى غرفة صغيرة طولها 3،25 م ، وعرضها 40 ، 2 م ، لها قبو مشابه لقبو القاعة المارة الذكر، وهناك كوة دائرية 2،40 في وسط هذه الغرفة كانت تستخدم للإنارة والتهوية.
إن جدران السرداب، وكذلك سلّمه مطلية بالجص، ولم نعثر على أي أثر للزخارف الجصية التي كانت سائدة في سامراء خلال القرن التاسع الميلادي.
وبعد الانتهاء من كشف تفاصيل هذا السرداب قامت الهيئة بدفنه خوفاً من تعرض السيارات المارة إلى حوادث السقوط فيه ليلاً.
ص: 33
2- تنقيبات في المتوكلية لموقع قبة هجول:
الاسم: قبة هجول، هي تسمية محلية لموقع صغير على شكل تل متوسط الحجم يرتفع عن الأرض المحيطة به حوالي 4 إلى 5 أمتار. لا يعرف سبب واضح لهذه التسمية حيث لم يرد لها ذكر في المصادر التاريخية المعاصرة لفترة سامراء ولا في المصادر الحديثة. ألا أن الرواية المحلية تقول: بأن في هذا الموقع سرداباً كان يرتاده راعي غنم بعد أن انهار البناء الذي كان يضم هذا السرداب وذلك في العصور المتأخرة وإن تسمية البناء جاءت من اسم هذا الراعي ( هجول) ، وليس لدينا في الوقت الحاضر ما يؤيد أو ينفي هذا الرأي بصورة علمية قاطعة.
الموقع: تقع قبة هجول في جنوب شرق جامع أبي دلف ويبعد الموقع الحالي أقل من كيلو متر عن الشارع الأعظم في قسمه المقابل الجامع أبي دلف، وتمر من شمال و شمال غرب و جنوب و جنوب غرب الموقع شوارع فرعية تتصل بشارع رئيس يؤدي إلى جامع أبي دلف من جهته الجنوبية، وهذه الشوارع هي بلا شك شوارع تعود للفترة التي سكنت بها المتوكلية قبل ما يزيد على ألف سنة.
التنقيبات : بدأت التنقيبات في هذا الموقع في الفترة من 10/7 ولغاية 1978/10/2 ، وقد أسفرت عن كشف تفاصيل مخطط بناية كبيرة الحجم نسبياً ذات شكل شبه منحرف (الأشكال 4-5) طوله 58 متراً وعرضه 35 متراً، استغل المساحة أي حوالي 700 متراً لإقامة مرافق البناء التي وزعت على المحور الطولي بشكل وحدتين بنائيتين متقابلتين تفصل بينهما ساحة مركزية مكشوفة.
ليس من السهل للوهلة الأولى التعرف على ماهية وما كان يراد بهذا المخطط. هل هو بيت سكن ؟ أم مرفق من المرافق الحكومية التي تعود إلى أحد دواوين الدولة ؟ ولترجيح أحد هذين الرأيين يجب علينا دراسة المخطط دراسة دقيقة وملاحظة جملة من النقاط التي لها علاقة بالموضوع والتي أبرزتها التنقيبات السابقة في سامراء.
ص: 34
إن معظم المخططات المتوفرة لدينا سابقاً عن العمارة المدنية العباسية في سامراء لقصور ملكية ضخمة كقصر الخلافة العباسية، قصر المنقور، القصر المعشوق المسمى محلياً العاشق والقصر العباسي في الحويصلات(1)، والدار رقم 4 في مدق الطبل (انظر الشكل 2)، ومن هذه النماذج القليلة في كميتها والكبيرة في أهميتها، لدينا صورة تكاد أن تكون كاملة عن تخطيط القصر العباسي وشكله، والذي يعود إلى الطبقة الحاكمة في المدينة، والذي من أبرز مميزاته المساحة الشاسعة والشكل الهندسي والأبراج الساندة ومجموعات الغرف والوحدات السكنية التي تتجمع حول ساحات مركزية مكشوفة بصورة متكررة على المحاور الطولية للقصر، وكذلك إبراز أهمية المداخل والواجهة الأمامية، والاعتناء بالتبليط والزخرفة والمواد الإنشائية الصلبة كالآجر والمرمر.
أما بيوت العامة فليس لدينا في السابق أمثلة كثيرة عنها حيث أنها لم تجذب قسماً من المنقبين الأجانب الذين عملوا في سامراء، ولكن من الأمثلة القليلة التي اكتشفت من قبل المنقبين العراقيين سنة 1936 - 1939(2) وتنقيبات الحارة السكنية العباسية في 1980 و 1981 ، والتي سوف نتطرق إليها في هذا البحث، لدينا صورة واضحة عن تخطيط وبناء البيت العراقي والذي يعود لطبقة العامة، والذي من أبرز مميزاته هي المساحة الصغيرة والساحة المركزية المكشوفة ذات الشكل الهندسي، والتي تطل عليها وحدتان سكنيتان على الطراز الحيري (3) إحداهما تحور أحيانا لكي تستخدم كمنافع عامة لأهل الدار، إن ندرة استخدام الآجر والزخارف الجصية هما ظاهرة جلية في هذه الدور.
أما مخطط بناية قبة هجول فإن دراسته تعكس المميزات التالية:
ص: 35
1 - المخطط ذو شكل شبه منحرف ليس له شبيه بين مخططات القصور الكبيرة ولا بين دور السكن الاعتيادية.
2- مساحة الأرض المخصصة للبناء صغيرة بالنسبة الى مساحة القصور وكبيرة بالنسبة إلى دور السكن الاعتيادية (1).
3- ليس هناك في المخطط أي مرفق من مرافق البناية له شكل هندسي اعتيادي مألوف، وهذه ظاهرة نادرة بالنسبة إلى العمارة العباسية في سامراء.
4 - وجود أبراج نصف دائرية، ظاهرة ليس لها وجود في دور السكن الاعتيادية، وعند وجودها في القصور الكبيرة غالباً ما تكون مبنية بالآجر أو اللبن.
5- إن استغلال المساحة الكلية للبناء وترك الباقي خالياً ووجود ثلاث ساحات مركزية كبيرة، ظاهرة تلفت الانتباه وليست مألوفة – على ما اعتقد – في العمارة العباسية في سامراء.
6- يلاحظ في المخطط غياب ظاهرة التناظر حول المحاور الرئيسة وهي ظاهرة سائدة في العمارة العباسية في سامراء.
7- يلاحظ أن المداخل في الأبنية العباسية غالباً ما يكون موقعها منتصف ضلع البناية، في حين أن المدخل الشرقي في قبة هجول جاء بشكل مخالف لهذه القاعدة (انظر المخطط الشكل 4) .
نستخلص مما سبق، أنّ مخطط قبة هجول لا تنطبق مميزاته على مخططات القصور الكبيرة ومع أن هناك بعض الشبه بمخططات بيوت العامة لكنه لا ينطبق
ص: 36
انطباقاً كافياً مع مواصفاتها الرئيسة، لذا فإننا نعتقد بأنّ المخطط ربما كان يراد به أن يكون لبناية دائرة حكومية تابعة لأحد دواوين الدولة، أما انحراف المخطط بالشكل الذي عليه فربما كان بسبب استقامة الشوارع المحيطة به من الجهات الشمالية الغربية، والجنوبية الشرقية.
المميزات المعمارية:
استمرت التنقيبات في هذا الموقع حوالى ثلاثة أسابيع، وكان الهدف منها معرفة ما يبطنه هذا الموقع الصغير الذي كنا نتوقع أن يحتوي على دار أو أكثر من دور السكن الاعتيادية والتي كنا نتوخى العثور عليها؛ لإغناء معرفتنا عن تخطيط وبناء وزخرفة مثل هذه العمائر المدنية البسيطة.
أثبتت التنقيبات أن هذه البناية مبنية بمواد إنشائية بسيطة جداً، وهي الطين المعمول بشكل طوف ومطلي بالجص من الخارج، ولم نعثر على الطابوق أو اللبن المنهدم في هذه البناية، كذلك يلحظ خلو هذه البناية من الزخارف الجصية أو الرسوم المائية الملونة التي كانت سائدة في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) في سامراء، ومن الملاحظ في هذه البناية أيضاً خلوها من أي من المرافق التي لابد منها في أي دار سكن مثل الحمام والمرافق الصحية، كذلك لم نعثر على أي من الآثار المنقولة خلال عمليات التنقيبات التي جرت في هذا الموقع.
إن سمك الجدران في هذه البناية يتراوح بين 85 سم في الداخل ومتر واحد في السور الخارجي، أما وجود الأبراج نصف الدائرية في بناية بمثل هذا الحجم ومنفذه بمثل هذه المواد الإنشائية البسيطة فأمر يجلب الانتباه.
إن وجود السرداب بقاعتيه الكبيرتين نسبياً (10 × 3،5 متراً)، (4،5× 3 متراً) ميزة معمارية مهمة وضرورية إن كانت البناية داراً للسكن أو دائرة حكومية، أما شكل السرداب وطريقة تنفيذه فإنهما يتطابقان تقريباً مع السرداب الذي تمت الإشارة إليه
ص: 37
سابقاً في البحث، أما مكونات البناية وتفاصيلها المعمارية فهي كالآتي:
البناية متكونة من قسمين رئيسين مع سرداب كبير نسبياً في القسم الأوسط من الجهة الجنوبية الغربية (انظر الشكل 5) .
1- القسم الواقع في الركن الشمالي الغربي من البناية: يتكون من ثلاث غرف متوسطة الحجم خلفه قاعة كبيرة (حوالي 10م ×5، 4م) لها مدخل يطل على الساحة الكبيرة للبناية، ومرتبطة مع الغرف بمدخل ثانوي آخر، وهو المفتوح على الغرفة الواقعة في الجهة اليمنى من هذه الوحدة البنائية أما أرضية الغرف والقاعة فإنها مبلطة بالجص الذي لا تزال آثاره باقية في الزوايا، وقد وجد على بعض أجزاء الجدران طلاء جصي أيضاً.
إن هذه الوحدة البنائية بغرفها الثلاث تطل بمداخلها على الساحة المركزية الوسطية المكشوفة البالغة 21 × 11،5 متراً، إن هذه المساحة في الواقع اشبه ما تكون بقاعة كبيرة مكشوفة وليس لها مدخل رئيس يربطها بالساحة الكبيرة الخارجية للبناية، ويتم ربطها على ما يبدو بواسطة مدخل الغرفة التي تفتح على القاعة الواقعة في الجهة الشمالية الغربية خلف الغرف الثلاث.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المظهر غريب، حيث جرت العادة في مثل هكذا ساحات أن يكون لها مدخل كبير واحد أو ثلاثة مداخل تعلوها عقود، وتطل على رواق كما هو معروف في ترتيب الغرف وعلاقتها بالفضاء الذي أمامها في تقاليد العمارة العباسية أو على الطريقة المعروفة بالنظام الحيري (1).
2 - القسم الجنوبي الغربي : ويشمل خمس غرف مختلفة الحجوم وذات أشكال منحرفة أشبه ما تكون بمربعات أو بمستطيلات غير منتظمة، اثنتان منها تطلان على الساحة الكبيرة الخارجية للبناية، أما الغرف الثلاث الباقية فترتبط فيما بينها وبين
ص: 38
الساحة المركزية الواقعة في الركن الجنوبي الغربي بمداخل تربطها مع الساحة المركزية الداخلية من جهة وبالساحة الخلفية التي تقع أمام الغرف الخمس، وهذه الساحة مغلقة أيضاً قياسها 15 × 10 أمتار، ليس لها مدخل خارجي يربطها بالساحة الكبيرة للبناية، ولا يتم ربطها بهذه الساحة إلا عن طريق الغرفتين المتداخلتين ذوات المداخل المشتركة مروراً بالساحة المركزية الداخلية في الجهة الشمالية الغربية وغرفها المطلة عليها ثم إلى الساحة الخارجية للبناية (انظر مخطط الشكل 4)، وقد عثر على آثار الطلاء الجصي في أرضيات وجدران هذا القسم من البناية.
3- السور الخارجي تم كشف السور عن طريق المجسات الاختبارية وتبين أنه مبني بالطوف ومدعم بأبراج نصف دائرية عددها (15) خمسة عشر معظمها قد تعرض إلى التلف والانهيار، أما المداخل الرئيسة لهذه البناية فهي اثنان، الأول في الاتجاه الشمالي الغربي يقع في وسط السور عرضه 2،25 متراً وبروزه عن مستوى السور حوالى 2،5 متراً، يحف به برجان. أما فتحة المدخل الخارجية فتبلغ 2،5 متراً بعمق 1،5 متراً ثم يضيق دهليز المدخل فيصبح 1،5 متراً بعمق مترين. ومن المرجح أن هذا المدخل كان مسقوفاً بقبو، وذلك استناداً إلى سمك جدرانه وإلى تفاصيله المعمارية الأخر.
أما المدخل الثاني فيقع في السور الشرقي وموقعه لا يتوسط السور ويشبه المدخل السابق في شكله العام وقياساته.
4 - السرداب: يقع السرداب في هذه البناية تحت وأمام الوحدة البنائية الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية (انظر المخططات الأشكال 4 ، 5) يدخل إليه بواسطة سلم متكون من صحنين وثلاث عشرة درجة. يدخل إلى السلم من الساحة المركزية الداخلية التي تفصل بين قسمي البناية الرئيسين.
لقد تعرض السلم إلى الانهيار وأصابه الضرر في معظم أجزائه، وهو يؤدي إلى
ص: 39
فناء صغير مقبى، وعلى يمين الداخل هناك حنية يعلوها عقد مدبب، إن هذا الفناء الصغير الذي يعمل عمل الموزع يؤدي في جهته اليسرى إلى مدخل معقود يؤدي إلى القاعة الرئيسة في هذا السرداب، وفي منتصف هذه القاعة وإلى الجهة اليمنى منها تقع القاعة الأصغر حجماً وهي متعامدة معها تشكلان حرف تي الإنكليزي، ولكون السرداب تحت الأرض فإن جدرانه لا زالت تحتفظ بطلائها الجصي بشكل جيد.
وأما الإنارة والتهوية في هذا السرداب فهي عن طريق فتحة دائرية في سقف القاعة الرئيسة في هذا السرداب
أن طريقة تنفيذ السرداب هي الحفر في الأرض الكلسية الصلبة، وهي بلا شك طريقة صعبة جداً ولا يملك المرء إلا الإعجاب بإصرار أولئك القوم ومثابرتهم في تخفيف وطأة الحر الشديد بحفر مثل هذه السراديب التي سبقت الإشارة إلى واحد منها في هذا البحث.
يتبين مما سبق أن هذه البناية لا تعبر بمخططها وموادها وطريقة تنفيذها عن أسلوب سامراء الناضج في العمارة لأسباب ليست معروفة لدينا ربما كان أحدها الاستعجال والسرعة في إكمال مثل هذه البنايات لأغراض الدولة المختلفة.
3- تنقيبات الموقع المسمى قبر (أبي دلف):
التسمية والموقع قبر أبي دلف، هو تسمية محلية لتل صغير في المتوكلية بيضوي الشكل أبعاده 23 × 17 متراً، يقع بالقرب من الشاطئ الشرقي لنهر دجلة، غرب جامع أبي دلف بحوالى كيلومترين، يبلغ ارتفاعه عن الأرض المحيطة حوالي 2،5 متراً. إلى الجنوب الغربي من التل هناك بقايا سور ضخم مبني بالحصى الكبيرة والجص ربما كان يعود بالأصل إلى قصر ضخم لشخصية عباسية مهمة، ويبدو أن التل يقع ضمن منطقة سكنية مهمة تزدحم بالقصور والأبنية المهمة.
إن تسمية الموقع بقبر أبي دلف لا نعرف متى بدأت ولماذا، وهل صحيح أن
ص: 40
الموقع يضم رفاة هذه الشخصية (1) التي أطلق اسمها أيضاً على جامع المتوكلية الكبير الذي بناه المتوكل.
لقد كان هدفنا الفعلي من وراء التنقيب في هذا الموقع هو احتمال كون المكان يحوي ضريحاً ربما كان للمتوكل نفسه الذي تقول المصادر بأنه قتل يوم الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين(2).
أما أبو دلف فإنه قد مات استناداً إلى المصادر التأريخية - سنة 226 ه_ ودفن في مكان مجهول لدينا قبل أن يعتلي المتوكل العرش بست سنوات (3)أي قبل أن يبني المتوكل مدينته بزمن يزيد على خمسة عشر عاماً فلا يعقل - والحالة هذه - أن يكون المكان قبراً لأبي دلف.
وقبل البدء بالتنقيب كانت التوقعات التي لدينا هي أن نعثر على بقايا ضريح أشبه ما يكون بالقبة الصليبية التي أقيمت بالجانب الغربي من نهر دجلة في الحقبة التي تلت عصر المتوكل (4).
التنقيب:
بدأت أعمال التنقيب في هذا الموقع في الأسبوع الثاني من شهر حزيران سنة 1979 ، واستمرت لمدة شهرين كشفت التنقيبات عن تفاصيل بناية صغيرة الحجم
ص: 41
نسبياً ذات شكل غير منتظم هندسياً (انظر الشكل 6 والشكل 7) أقصى طول له هو 20،25 م وأقصى عرض له هو 16،5 م. وقد نفذ البناء بمواد إنشائية غير موحدة من بينها الطابوق والحصى الكبيرة واللبن والجص ، أما جدرانها فذات سمك مختلف يتراوح بين المتر وبين النصف متر، مطلية بالجص الذي لا يزال قسم كبير منه يشاهد على الجدران الداخلية وقد تبين من جراء التنقيب أن هناك بناءً ملاصقاً ظهرت جدرانه في الواجهة الشرقية ليس من السهل للوهلة الأولى معرفة ماهية مخطط هذه البناية، ويبدو أنه يحتوي على المكونات والتفاصيل التالية:
1 - صحنين رئيسين مفتوحين، (انظر الشكل 6 الأرقام 1،6).
2 - قاعتين متجاورتين، الأرقام 5، 4 .
3- مجموعة غرف صغيرة غير منتظمة هندسياً، الأرقام 10،8،7،3 .
4- قاعة كبيرة (رقم 9) داخلها بناية (رقم 10) مربعة من الخارج ومثمنة من الداخل يرقى إليها بواسطة ثلاث درجات من الساحة المركزية (رقم 6).
5 - مئذنة أسطوانية الشكل شمال الغرفة رقم 11 ، يصعد إليها بواسطة سلّم مفتوح على الساحة رقم 6 ما تبقى منه متكون من ست درجات.
إن مخططاً يحتوي على التفاصيل المارّة الذكر غير مألوف بين مخططات العمائر العباسية الدينية والدنيوية في سامراء، حيث إن كان المراد بالمخطط هو البيت، فالبيت العباسي معروف بنظام تخطيطه وبواجهته الثلاثية المطلة على الصحن المركزي المكشوف. أما وجود المئذنة فهي ظاهرة غير مألوفة أيضاً داخل البيوت، ويقتصر وجودها على الجوامع كما هو معروف. أما إذا كان الهدف المخطط من هو بناء جامع أو مسجد صغير فلمثل هذه الأبنية مخططاتها المعروفة والسائدة في تلك الفترة والتي تعتمد بالدرجة الأولى على الشكل الهندسي والتناسق المحوري والتناظر بين أجزائها والذي لا وجود له في مثل هذا المخطط غير المنتظم هندسياً.
ص: 42
أما إذا أريد بهذا المخطط أن يكون بناية ضريح، فالضريح بتلك الفترة له شخصيته المعمارية الواضحة كما هو معروف بالقبة الصليبية (1).
اما البناية المثمنة في هذا المخطط فإننا وان كنا لا نستبعد كونها ضريحاً جاءت هنا بشكل غير مدروس وثانوي وجزء من مكونات معمارية اخرى أشرنا إليها فيما سبق.
المميزات المعمارية :
يدخل إلى هذه البناية من الجهة الغربية المواجهة لنهر دجلة بواسطة مدخل بسيط خالٍ من أية مميزات معمارية والتي غالباً ما تؤكد شخصية المدخل في تلك الفترة كالأبراج أو الدعامات، يؤدي المدخل إلى دهليز ضيق ويؤدي بدوره إلى الساحة الرئيسة رقم 6- أما الدهليز فإنه مفتوح في جهته اليمنى بفتحتين، الأولى تؤدي إلى بقايا سلّم متكون من خمس درجات والثانية إلى غرفة صغيرة (رقم 2) يصعد إليها بدرجتين فيها بقايا حوض دائري مبني بالطابوق والجص قطره 50 سم وبقايا مرحاض شرقي بطول 72سم ومجرى لتصريف المياه. وعلى الأرجح إن هذه الغرفة كانت بالأصل تقوم بوظيفة المرافق والحمام في هذه البناية.
الساحة المركزية رقم 6 هي أكبر ساحة مكشوفة في هذه البناية (الشكل 8)، وهي مبلطة بالطابوق المطلي قياس 32 × 32 × 5 سم تفتح عليها من جهة الغرب الغرفتان 7 و 8 غير المنتظمتين هندسياً، وبعد رفع الأتربة والأنقاض ظهرت أرضيتهما مبلطة بالجص والغرفة 8 لا تزال تحتفظ بكونها ذات العقد المدبب والتي ربما كانت بالأصل تستعمل لوضع مسرجة الأضاءة. إن هاتين الغرفتين تكونان غرفتي نوم مناسبة المساحة لسكنة هذه البناية.
ص: 43
اما من الجهة الشرقية، فقد كشف عن القاعة رقم 5 وكانت منسقة تنسيقاً بديعاً وذات شكل مستطيل منتظم (9 ×7 أمتار) ، وقد زيّن جدارها الشرقي بثلاث دخلات، تعلوها عقود مدببة تفصل بينها دعامات مبنية بالآجر تقوم بمهمة الأسناد السقف القاعة الذي نفذ بهيئة قبو، ويلاحظ بين هذه الدخلات الكوى المخصصة لوضع معدات الإضاءة (انظر الشكل 7).
في الجهة الشمالية الغربية من هذه القاعة تم الكشف عن دخلة في الجدار تحف بها من الجهتين آثار لعمودين أسطوانيين ربما كانا بالأصل يحملان على تاجيهما عقداً يساهم مع العقود الثلاثة في الجهة الشرقية بدعم السقف المقبى لهذه القاعة. إن أرضية هذه القاعة قد بلطت بالجص الذي لا تزال بقاياه بحالة جيدة من الحفظ. في الزاوية الشمالية الشرقية في الساحة رقم 6 تم الكشف عن غرفة صغيرة (10 × 1،5 متراً) وهي صغيرة إلى درجة لا تكفي لنوم شخص (انظر الغرفة 11 في المخطط الأرضي)، ولكنها تصلح للخزن.
تقع خلف هذه الغرف بقايا مئذنة صغيرة مبنية بالحصى الكبيرة والجص وذات بدن أسطواني يدور داخلها سلّم حلزوني باتجاه معاكس لعقرب الساعة متكون من ست درجات يدخل إليها بمدخل ضيق سعته حوالي نصف متر يقع في الجهة الغربية من المئذنة وهو ضيق إلى درجة لا تكفي لدخول إنسان اعتيادي بشكل مريح، وقد عثر بين الأنقاض وبالقرب من المدخل على بقايا قطعة خشبية من نوع الساج لسنا متأكدين إن كان لها علاقة بهذه المئذنة الصغيرة (الشكل 9) .
تعتبر هذه المئذنة - بالرغم من صغر حجمها - المثال الوحيد من نوعه والذي تم الكشف عنه في سامراء العباسية، حيث إن تصميم المآذن في سامراء استناداً إلى النماذج التي وصلتنا هي ذات شكل ملوي كما هو الحال في الجامع الكبير في سامراء وجامع (أبي دلف) في المتوكلية.
ص: 44
إن هذه المئذنة تقدم الدليل القاطع على أن المئذنة ذات البدن الأسطواني والسلّم الحلزوني الذي يدور داخلها والتي شاع استعمالها في العراق في العصر العباسي الأخير، القرن السادس الهجري (الثامن عشر الميلادي) وما بعده الأشكال (12،10)، كانت معروفة في سامراء في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) (1).
أما الجهة الشمالية من الساحة رقم (6) فتطل عليها ثلاث فتحات الأولى إلى اليمين، وهي فتحة المئذنة المارة الذكر، وفي المنتصف فتحة تؤدي إلى القاعة رقم (9) ، ومنها إلى البناية ذات الشكل المربع من الخارج والمثمن من الداخل، ويصعد إلى أرضيتها المبلطة بالآجر قياس 32×32سم بواسطة سلّم صغير متكون من ثلاث درجات عرضها (60 سم).
إن أقصى ارتفاع مما تبقى من جدران بناية الضريح هو 105 سم، وأدنى ارتفاع هو 25 سم عن مستوى سطح الأرض المحيطة بها في القاعة رقم 9 التي تضم بناية الضريح رقم 10 .
إن أرضية بناية الضريح ظهرت مكسورة من منتصفها لعمق 70 سم، ولا نعرف سبباً لذلك وهي صلبة جداً ومبنية بالطابوق والجص ، وربما كان سبب الكسر والتهديم الحاصل بها هو من جراء عمل سراق الآجر الذين لعبوا دوراً خطيراً في إزالة الكثير من المعالم الأثرية في سامراء وبقية المواقع الأخر في العراق. وقد قمنا من جانبنا بعمل مجسّ في منتصف أرضية بناية الضريح علّنا نكشف بعض عظام بشرية في هذا المكان، ونزلنا في هذا المجسّ بعمق 50 سم ولم نحصل على شيء. وكان الطابوق
ص: 45
والجص لا يزال مستمراً وصلباً جداً.
ويلاحظ من أسس هذه البناية ومخططها بأنها كانت مسقوفة بقبة، وإن صح ذلك ففي هذه الحالة لابد من أنها كانت مخصصة لكي تصبح ضريحاً لرفاة شخصية دينية مهمة عاشت في زمن المتوكل وسكنت في مدينته المتوكلية.
ومن الجدير بالذكر أن الأضرحة الإسلامية ذات المخطط المثمّن كانت معروفة في سامراء في تلك الفترة كما هو موجود في القبة الصليبية ولم يقتصر تخطيط المثمن على المدافن والأضرحة وإنما شاع استعماله في البيوت الضخمة والمهمة أيضاً، والدار رقم 4 في موقع مدق الطبل إلى الجنوب من قصر باب العامة يقدم لنا مثالاً طيباً للمقارنة (1).
أما في الجهة الشمالية الغربية من الساحة رقم 6 فهناك مدخل القاعة 9، وقد عثر في لصق جدار هذه القاعة الشمالي على دكة مبلطة بالجص ترتفع عن مستوى الأرضية بمقدار 5 سنتيمترات (انظر الشكل 7).
بعد رفع الأتربة والأنقاض عن القاعة رقم 9 ظهرت أرضيتها بمستويين مختلفين القسم الشرقي المقام عليه الضريح المفترض ينخفض عن القسم الغربي بحوالي 20 سنتيمتراً.
أما مدخل الضريح المفترض بالقرب من ركن الغرفة الصغيرة رقم 11 عثر
ص: 46
فيه على بقايا عمود رخامي مثبت في مكانه الأصلي (الشكل 8) ارتفاعه 65 سم وقطره 36 سم، وهو ذو لون رمادي فاتح مبقع ببقع صغيرة زرقاء اللون، وفي الجهة المقابلة هناك آثار مكان العمود الثاني الذي لم نعثر عليه، ربما كان هذان العمودان في الأصل يحملان عقداً كبيراً ويشكلان طارمة مفتوحة على الساحة رقم 6، وقد تبين أنّ الأرضية في هذا الجزء من الساحة رقم 6 ترتفع عن مستوى باقي أجزاء الساحة بحوالي 10سم.
أما الجزء الجنوبي من البناية فإن أبرز مكوناته هي الساحة المكشوفة رقم 1 وهي مبلطة بالطابوق المطلي الجيد قياس 32 × 32 سم، وقد تم العثور على حنية ذات مقطع مستطيل في جدارها الجنوبي، فلو افترضنا كون هذه الحنية محراباً فإن الساحة - والحالة هذه - لابد أن تكون مصلّى صيفياً، لأن الحنية آنفة الذكر متجهة باتجاه مكة ومتماثلة مع اتجاه محراب جامع (أبي دلف).
من الجدير بالذكر أن الساحة رقم 1 متصلة بالساحة رقم 6 عن طريق مدخل على يسار الداخل منه إلى الساحة رقم 1 على عمودين جصيين مزدوجين لصق الجدار، وهذا النوع من الأعمدة شائع في أبنية سامراء كما أثبتت الحفريات ذلك (1).
وفي وسط الساحة رقم 1 عثرنا على بقايا دعامة ذات مقطع مستطيل (الأشكال 7، 6) ارتفاعها حوالي 120 سنتيمتراً، وفي جزئها الأسفل وعلى ارتفاع 35 سم من الأرض المحيطة بها هناك دخلة صغيرة بعمق 8 سم ثبتت في أسفلها رخامة ملساء عرضها 28سم، ذات لون أزرق فاتح خالية من الكتابة، ولسنا متأكدين بالضبط فيما إذا كانت هذه الدعامة محراباً ثانيا أم شاهد قبر أم بقايا دعامة كانت تشكل مع الجدارين الواقعين على يسارها ويمينها مرتكزا لعقدين لحمل سقف هذه الساحة. واذا صح افتراضنا الأخير هذا فيكون عندنا مسجد صغير متكون من أسكوبين طوله 6،5 مترا وعرضه 5 ، 5 متراً.
ص: 47
القاعة رقم 4 تتصل مع الساحة رقم 1 بمدخل، وقد عثر على حنية في جدارها الجنوبي متجهة هي الأخرى باتجاه القبلة مرسومة بالجص بطريقة القالب على شكل عضادة ارتفاعها 120 سم عمقها 3 سم وعرضها 100 سم، كذلك تم العثور على بقايا حنية أخرى مشابهة لها في الجدار الجنوبي للغرفة رقم 3 طولها 97 سم وعرضها 90 سم.
استناداً إلى ما مر ذكره من تفاصيل تتعلق بمخطط وعمارة هذه البناية، فإن رأياً قاطعاً في هويتها هو بلا شك من الأمور الصعبة، ولكننا - والحالة هذه – نستطيع أن نرجح كون هذه البناية ربما كانت بالأصل داراً حوّرت فيما بعد لكي تضم ضريحاً وقاعة لبعض رجال الدين الذين يجتمعون معاً للمناظرة وتبادل الآراء، وأنسب مكان لذلك هو القاعة رقم 5. أما القاعة رقم 4 فربما كانت مصلّى أو مسجداً لفصل الشتاء، وهي بلا شك تصلح للجلوس والمناظرة أيضاً، والساحة رقم 1 مصلّى صيفي على أقل احتمال إن لم تكن مسقوفة، أما الغرف 3 ، 7، 8 فهي غرف نوم مناسبة الحجم، والغرفة الصغيرة رقم 11 ربما كانت مخزناً لبعض حاجات الساكنين في هذه البناية. أما الغرفة أو المرفق رقم 2 فهو بلا شك مكان المرافق والحمام. إن وجود المئذنة والحنيات الجدارية المتجهة جنوبا باتجاه القبلة وكذلك البناء الذي افترضنا كونه ضريحاً، وكل هذه الأدلة تشجع على ترجيح كون البناء ربما كان زاوية (أو ملاذاً) لجماعة دينية معينة يتعبدون ويتذاكرون بالقرب من ضريح شيخ طريقتهم أو أحد مرشديهم المهمين الذي ربما كان هذا البناء يعود له بالأصل. وتشير المصادر التأريخية إلى أن القرن الثالث الهجري قد شهد انتعاش ونشاط بعض الفرق الدينية ومنها فرقة المعتزلة التي كانت تنعم بتأييد الخليفة المعتصم منذ كان في بغداد وقبل أن يتحول عنها إلى مدينته الجديدة سر من رأى (1) .
ويبدو أن البناء قد هجر بعد - أو ربما قبل - هجر المتوكلية اثر مقتل الخليفة
ص: 48
المتوكل لثلاث خلون من شوال سنة 247 ه_ المصادف 11 كانون الأول 861م (1).
4 - تنقيبات الحارة السكنية العباسية (بالقرب من الملوية):
الحارة السكنية العباسية هو اسم مؤقت لموقع حفريات هيئتنا التي بدأنا بها بداية شهر آب سنة 1979 ، ودامت حفرياتنا إلى نهاية شهر آذار سنة 1981 بقوة عمالية بسيطة قوامها حفاران شرقاطيان وخمسة عشر عاملاً محلياً .
إن موقع الحفريات يعتبر من المناطق السكنية المزدحمة في العصر العباسي، ومن أولى المناطق التي ازدهرت بعد بناء سامراء زمن المعتصم والواثق، وقبل أن تبنى المتوكلية إلى الشمال من المدينة في عهد المتوكل، وذلك لسبب قربها من الجامع الكبير، فتكون والحالة هذه ربما تعود إلى الحملة البنائية الأولى التي تمت في موقع سامراء في عهد تأسيسها الأول. هذا وإن التنقيبات قد أثبتت كون هذه المنطقة هي من المناطق السكنية المكتظة والتي كانت مخصصة للطبقة العامة والحرفيين.
يحد الموقع من جهة الغرب نهر دجلة ومن جهة الشرق بقايا البناية المعروفة محلياً بسور عيسى، وكذلك الجامع الكبير ، ومن جهة الشمال المنطقة الأثرية التي تتصل بمدق الطبل، ومن ثم بأسوار قصر الخليفة، (أو قصر باب العامة).
أما من الجنوب فتحده أبنية ودور مدينة سامراء الحديثة والتي يفصلها عن الموقع شارع حديث يربط سامراء بمدينة الدور إلى الشمال من مدينة سامراء.
كان وراء انتقائنا هذا الموقع للتنقيب فيه سببان الأول هو أهمية المنطقة، واكتظاظها بالمعالم الأثرية، وقربها من الجامع الكبير وقصر باب العامة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قامت مديرية الآثار العامة في منتصف الستينيات بالحفر في هذه المنطقة، وتم اكتشاف بيت عباسي كبير بديع التكوين غني جداً بالزخارف الجصية أطلق عليه اسم (بيت الزخارف) سبق وأن أشرنا إليه ، وهذا البيت يقع مباشرة على
ص: 49
الحدود الغربية للموقع المراد الحفر فيه من قبلنا، لذا فإننا أردنا والحالة هذه أن نقف على ارتباطات هذا البيت بالبيوت أو الشوارع التي تقع بالقرب منه، وكذلك اعتقادنا بأن الموقع ربما يكون يحوي على بيوت عباسية مشابهة من حيث التكوين المعماري والزخرفة الجصية الغنية.
أما السبب الثاني: فهو محاولة إيقاف الزحف العمراني للمدينة الحديثة من جهة الشرق حيث قام الكثير من المواطنين حوالي أربعمائة عائلة (حسب الإحصائيات الرسمية) بالتجاوز على هذه المنطقة الأثرية ببناء دور لهم فيها، مما يؤدي إلى تخريبها وضياع معالمها الأثرية.
يرتفع الموقع عن مستوى الشارع من جهة الجنوب بين مترين إلى 3 أمتار ويبلغ طول الموقع الذي خصص للتنقيب حوالي 105م وعرضه 35 متراً، وبذلك تكون مساحة الموقع حوالي 3675 متراً مربعاً (الشكل 13 و 14).
كانت طريقتنا بالحفر هى اختيار أعلى نقطة بالموقع والنزول فيها بعد جرد القشرة الأرضية ورفع الأنقاض والأتربة وتعقب الجدران والوصول إلى أرضيات الغرف التابعة إلى الوحدات السكنية، وقد قمنا برفع ما يزيد على أحد عشر ألف متر مكعب من الأتربة والأنقاض، وتم لنا إبراز كافة تفاصيل الوحدات السكنية في الموقع.
كشفت التنقيبات في هذا الموقع عن مجموعة من البيوت المختلفة الحجم، حيث تتراوح مساحتها بين 350 متراً مربعاً و 170 متراً مربعاً، وقد حاولنا حصر عددها وتشخيص مخططاتها بصورة أولية إلى أحد عشر بيتاً (الشكل 12) لكل واحد منها ملامحه التخطيطية والمعمارية الخاصة به كالساحة المركزية والمدخل المؤدي إليه والمفتوح مباشرة أو غير مباشرة على زقاق خارجي، وقد وجد أن البعض من هذه البيوت تتصل مع بعضها البعض بمداخل وفتحات تبدو أحياناً معمولة بعد بناء
ص: 50
هذه البيوت لأسباب ربما تكون اجتماعية مثل توسع العائلة وانتشارها مع ضرورة المحافظة على سهولة الاتصال للإبقاء على الرابطة العائلية القوية في المجتمع العربي الإسلامي.
إن هذه البيوت تختلف في مساحتها ونوعية بنائها وغناء زخارفها، وتستقل بمداخلها الخاصة المفتوحة على الأزقة التي تمر من أمامها مما يعكس اختلافاً وتبايناً في المستوى الاقتصادي لسكنة هذه البيوت نكون والحالة هذه امام حارة سكنية تتألف من مجموعة هذه البيوت العباسية المسكونة على الأرجح من قبل طبقة شعبية حرفية ذات مستوى اقتصادي و اجتماعي متباين.
ولأغراض البحث قسمت بيوت هذه الحارة إلى ثلاث مجاميع ، البيوت المرقمة 1، 2، 3، هي المجموعة الجنوبية، والبيوت المرقمة ،4، 5، 7،6 هي المجموعة الوسطية، أما المجموعة الشمالية فتتألف من البيوت المرقمة ،8، 9 ، 10 ، 11 (الأشكال 14 ، 22).
لقد كشفت التنقيبات عن وجود زقاق ضيق عرضه ثلاثة أمتار ونصف، يفصل مجموعة البيوت الجنوبية عن المجموعة الوسطية، ويمر من الغرب باتجاه الشرق، ويتصل اتصالاً مباشراً بزقاقين في هذين الاتجاهين.
لقد ثبت لنا من جراء التنقيب أيضاً أن الزقاق الواقع في الجهة الشرقية، من الحفريات يفصل موقع بيت الزخارف الذي سبقت الإشارة إليه وبين هذه الحارة السكنية، أما الزقاق الذي يمر من الجهة الغربية فتقع عليه مداخل البيوت المرقمة 3، 4 ، 5، ويتصل مع مجموعة البيوت الشمالية المرقمة 8، 9 ، 10 ، 11 بواسطة زقاق خاص ضيق يقوم بوظيفة الموزع عرضه متر ونصف (الشكل 17).
إن مجموعة البيوت الجنوبية في هذه الحارة متصلة مع بعضها بواسطة فتحات في البعض من جدرانها المشتركة، فالبيت رقم 1 متكون من ساحة مركزية مفتوحة
ص: 51
تطل عليها مباشرة من الجنوب غرف ثلاث (أ، ب، ج) بدون رواق أمامي، وهذا ما يسمى بالطراز الحيري البسيط وقد ظهرت باقي أجزاء البيت مخرّبة، ولم يبقَ أثر التباليطه الآجرية الأرضية.
من حسن الحظ فقد ظهرت جدران الغرفة (ب) في هذا البيت لا تزال تحتفظ بالبعض من زخارفها الجصية الجميلة (انظر الشكل 15)، وقوامها أطر هندسية متقاطعة تؤلف نجمات ثمانية الرؤوس ومربعات ومثلثات تملؤها عناصر نباتية كالوريدات الكأسية والعناصر الشبيهة بكيزان الصنوبر المحورة عن الطبيعة، كما يلاحظ التحزيز الدقيق على هذه العناصر الزخرفية مما يدل على أن هذه الزخارف نفذت بالأسلوب الثاني وهذا يعود تاريخياً إلى الأدوار الأولى لبناء سامراء.
أما الأسلوب الأول فهو أسلوب الحفر الغائر حيث كانت زخارفه تمتاز بكثرة عناصر عناقيد وأوراق العنب المنفذة بهذا الأسلوب، ولقد عثر على مثل هذه الزخارف الجصية في الحفريات التي قامت بها مديرية الآثار العامة في عام 1936 (1) (انظر الشكل 23) .
البيت رقم 2 يمتاز بتعدد الغرف، والواقع بعضها في الزاوية الشمالية والجنوبية الغربية، وفي المرفق (أ) تم اكتشاف بقايا سلّم يتألف من درجتين، وهذا يدل على أن للبيت سطحاً مستوياً ربما كان يستخدم للنوم في فصل الصيف كما هو معمول به في الوقت الحاضر في الأقسام الوسطى والجنوبية من العراق.
البيت رقم 3 يقسم إلى قسمين، القسم الشمالي والقسم الجنوبي، تفصل بينهما ساحة مركزية لا تزال تحتفظ بجزء من تباليطها الأرضية الآجرية من قياس 32 × 5 سم، ويبدو أن الجزء الشمالي من هذا البيت والذي يضم المدخل، يتألف من
ص: 52
مجموعة من الغرف استخدمت كمنافع عامة لأهل البيت، وهذا الجزء قد تعرض إلى تحوير ونقص وتخريب في فترات مجهولة.
القسم الجنوبي من هذا البيت يتألف من تخطيط هندسي بديع ومتكامل ويتألف من ثلاث غرف (ب، ج ، د) تفتح على الرواق (أ) الذي بدوره يطل بثلاث فتحات على الصحن المركزي، وعلى الأرجح فقد كانت هناك عقود تتوج هذه الواجهة الثلاثية المطلة على الصحن، وهذا ما يدعى بالأسلوب الحيري الكامل (او الناضج).
أن من المميزات المعمارية البديعة والفريدة في هذه الدار والرواق (أ) في قسمه الشرقي في هذا البيت يشكل مصطبة معمولة بالجص ترتفع عن الأرض حوالي نصف متر، أما في الزاوية الجنوبية الغربية، فقد عثرنا على درج يتكون من أربع درجات طول الواحدة منها متر واحد وعرضها 30 سنتيمتراً.
ومن الجدير بالذكر أن درجاً بهذا الموقع هو فريد من نوعه، حيث لم يسبق لنا في حفرياتنا هذه ولا في الحفريات التي سبق القيام بها من قبل مديرية الآثار العامة سابقاً إن كشفت مثل هكذا درج في بيت عباسي من هذا النوع، حيث إن المعتاد هو أن يكون الدرج يوازي الجدار ويستند إليه في بنائه
أما مجموعة البيوت الوسطية فإن أبرزها هو البيت رقم 4 الذي يتميز بصحنه المركزي الكبير ( 5 ، 13 × 11م) بالنسبة إلى باقي بيوت هذه الحارة، وهذا الصحن لا زال يحتفظ بكافة تباليطه الآجرية قياس 32 × 32 × 5 سم، وطريقة الرصف في هذا الصحن هي طريقة اعتيادية بسيطة عبارة عن خطوط متوازية، إن الآجر في هذا الصحن هو بحالة جيدة ونوعيته فاخرة بالرغم من مرور ما يزيد على 1000 سنة على بنائه، وقد كشفنا عن بالوعة لتصريف المياه في القسم الشمالي من هذا الصحن.
تطل على هذا الصحن في الجنوب ثلاث غرف ورواق مرتبة بشكل هندسي جيد على طريقة الطراز الحيري الكامل.
ص: 53
أما القسم الشمالي في هذا البيت فيضم مدخل البيت وغرف الحمام والمطبخ وباقي المنافع الأخر (شكل 13) ، ولا زال الحمام وأجزاء من أرضية المطبخ تحتفظ بطلائها القيري، هذا وقد ظهر تبليط أرضية إحدى الغرف في القسم الشمالي بشكل يختلف عن الشكل الاعتيادي، حيث رصف الآجر بخطوط مائلة، وقد نتج ذلك عن طريق رصف الآجرة المربعة على إحدى زواياها.
ترتبط بالجهة الشرقية للبيت رقم 4 وحدتان بنائيتان ( 4 أ ، 4 ب)، ويتم الاتصال بين البيت رقم 4 والوحدة البنائية (4 أ) عن طريق مدخل في الجهة الشمالية الشرقية للغرفة (د) الواقعة في القسم الجنوبي الشرقي للبيت رقم 4 ، وقد عثرنا على سلم متكون من 6 درجات يقع في الغرفة (ب) الواقعة في الجنوب الشرقي للوحدة البنائية (4 أ ) .
أما الوحدة البنائية ( 4 ب) فتتصل بصحن البيت رقم 4 بواسطة مدخل يفتح مباشرة على الصحن، وقد عثر على زخرفة جصية على الركن الخارجي الغربي لمدخل الغرفة (ب)، وعثر على مثيلاتها في حفريات مدق الطبل في سامراء (1) وهناك من جهة الشمال الشرقي لهذه الوحدة البنائية مجموعة من الغرف الصغيرة وقد عثر في مدخل الغرفة (ج) على إطار يحمل زخرفة جصية يؤطر المدخل من الخارج قوام زخرفته أشكال تجريدية مكررة نادرة الوجود، حيث يوجد شبيه واحد بها يؤطر المحراب الجصي الذي عثر عليه في حفريات سامراء (2).
أما باقي أجزاء الواجهة إلى الشرق فقد ظهرت مخربة ومنقوضة.
وبالرغم من كون البيت رقم 4 هو بيتاً متكامل التخطيط وبه كافة العناصر الضرورية للسكن، إلا أننا نرجح كون الوحدتان البنائيتان 4 أ، 4 ب تعودان له،
ص: 54
وربما نُفذتا بعد أن اتسعت العائلة وأصبحت الحاجة ماسة إلى مزيد من الغرف، إن هذا البيت مثل باقي البيوت في المجموعة الجنوبية، مبني بواسطة اللبن والطوف ومطلي بالجص.
البيت رقم 5 يتميز بطرازه الحيري الكامل ويتصل بالبيوت رقم 6 ، 7 عن طريق فتحة في القسم الجنوبي الشرقي للغرفة (و) (انظر الشكل 12).
التباليط الأرضية الآجرية في هذا البيت لا زالت في معظم أجزائها بحالة جيدة من الحفظ، وقد اسعفنا الحظ في العثور على زخارف جصية بديعة على جدران الغرفة الوسطية (ب) الواقعة في منتصف القسم الجنوبي من هذا البيت، ويلاحظ بأن هذه الغرفة هي في الحقيقة أشبه ما تكون بإيوان يفتح على عرضه إلى الرواق الذي أمامه، وهذا بدوره يفتح على الصحن المركزي للدار بثلاث فتحات، وعلى الأرجح فإن هذه الفتحات كانت تعلوها عقود.
لقد ظهرت الزخارف في هذا الإيوان على كافة الجدران بارتفاع متوسط 60سم، وهي بحالة جيدة من الحفظ (انظر الشكل 13)، تتألف هذه الزخارف من أشكال تجريدية مكررة تبدو من نوعية صناعتها بأنها قد نفذت بطريقة القالب، وهو الأسلوب الصناعي الزخرفي الذي شاع في الفترة الأخيرة في سامراء، ويعرف بالأسلوب الثالث، وقد كشفت مثل هذه الزخرفة في أماكن متعددة في حفريات مديرية الآثار العامة عام 1936 (1).
أما المجموعة الشمالية في بيوت الحارة السكنية فيدخل إليها من الجهة الغربية بواسطة زقاق خاص ضيق يرتبط ارتباطاً مباشراً بالزقاق المار من الجهة الغربية لهذه الحارة، وقد عثرنا على بقايا مدخل لهذا الزقاق، ولربما كان هناك باب لغلق هذا الطريق الخاص أثناء الليل .
ص: 55
يؤدي هذا الزقاق الخاص مباشرة إلى البيت رقم 8 (انظر الأشكال 12، 17) ويتألف من صحن مركزي كبير تطل عليه من الجنوب مجموعة من الغرف تفتح على رواق، والرواق بدوره يفتح على الصحن بفتحات ثلاث، أما باقي أقسام البيت الواقعة إلى الشرق فظهرت منقوضة ومخربة، وقد عثر في الجدار الجنوبي للغرفة (أ) في هذا البيت على زخرفة جصية تجريدية مبسطة جداً، معمولة بطريقة القالب (الشكل 18) أو ما يسمى بالأسلوب الثالث (1) .
البيت رقم 9 ربما كان بالأصل يستخدم كورشة صغيرة مستقلة (انظر الشكل 19) أو ربما كانت لها علاقة بورش أخر صغيرة قريبة منها وقد كشفت التنقيبات في هذا البيت عن بقايا أفران وآثار حرق ورماد في القسم الشمالي من الغرفة (أ) ربما كانت تستعمل لشي الفخار، وعلى بقايا أحواض تقع لصق الجدار الجنوبي لنفس الغرفة، كذلك كشفنا عن درج يتألف من أربع درجات، الرابعة مخربة طولها 90 سينتمتراً وعرضها 25 سينتمتراً وارتفاعها 30 سينتمتراً، وعثرنا على كسر الجرار خزن كبيرة الحجم، إن المكتشفات في هذا البيت تدل على أن صاحبه ربما كان من الحرفيين البسيطين المشتغلين في مهنة صناعة الفخار وهذا البيت ربما كان ورشته التي ينتج فيها بضاعته.
أما البيت رقم 10 من بيوت المجموعة الشمالية فيعتبر من أهم بيوت الحارة (انظر الشكل 19)، ويبدو هذا واضحاً من دقة تخطيطه الهندسي وحجمه حيث تبلغ مساحته 280 متراً مربعاً، وكذلك وفرة زخارفه ودقة صناعتها وجودة وجمال نظام رصف تباليطه الأرضية الاعتيادية بالنسبة إلى باقي الدور، وبالإضافة إلى ما مر ذكره من مميزات هناك ورشة صغيرة ملحقة به في الجهة الجنوبية الغربية منه (انظر الشكل 19).
يدخل إلى هذا البيت عن طريق مدخلين الأول عن طريق الزقاق الخاص ويقع
ص: 56
على يسار الداخل في الزقاق، وهو مدخل ضيق ثانوي يؤدي إلى غرفة تؤدي بدورها إلى الورشة، وقد تم كشف ما يشبه الموقد مبني بالطين ربما كان يستعمل لصهر المعادن، تجري داخله ساقية صغيرة، ومبيض بالجص، وأمام هذا الموقع هناك مقعد صغير مبني بالطين ومبيض بالجص أيضاً ربما كان الجلوس العامل، وقد تم العثور بالقرب من هذا الموقع على كتل لمواد منصهرة (1)، وعلى جرّة معدنية صغيرة في أسفلها ثلاثة ثقوب (الشكل 21)، كذلك آلة معدنية مسنّنة الحافة ربما كانت تستعمل لتحزيز المواد الفخارية، وهناك احتمال كون هذه الورشة لها علاقة بالورشة التي سبق ذكرها في البيت 9 ، وربما كانت هذه الورشة متخصصة في الصناعة التزجيجية والأدوات الفخارية والزجاجية الرقيقة.
إن المدخل الرئيس للدار رقم 10 يقع في الزاوية الشمالية الغربية، حيث يؤدي المدخل إلى دهليز أو مجاز ضيق طوله أربعة أمتار ونصف، وعرضه حوالي متر، مبلّط بالآجر قياس 30×30 × 5 سم بشكل جميل مرصوف بخطوط مائلة، يؤدي هذا المجاز إلى الصحن المركزي الذي تبلغ مساحته 42 متراً مربعاً، ومبلط بصورة فنية بتباليط آجرية من نفس القياس، مراعى فيه التأثير الزخرفي وإتقان الصنع، حيث يبدأ الرصف اعتباراً من الجدران بصفّين من التبليط حول الصحن رصفاً بشكل مغاير، حيث رصفت الآجرّة على إحدى زواياها، تحفّ بها من الجانبين نصف آجرة مرصوفة بنفس الطريقة، ثم صفّ من الآجر بشكل مستقيم.
أما المساحة الوسطية الباقية في الصحن فقد رصفت بخطوط مائلة (انظر الشكل 19) وهذه التغييرات في وضع الآجر أعطت للصحن منظراً جميلاً.
ومن هذا الصحن يصعد إلى سطح المنزل بواسطة سلّم عثرنا على بقاياه في الجهة الغربية من الصحن.
تطل على الصحن من الناحية الجنوبية قاعة كبيرة نسبياً، وأمامها رواق على
ص: 57
شكل حرف (T) الإنكليزي، وهذا التخطيط يذكرنا بجذوره العميقة في العمارة العراقية، وبالأخص في بناء المعابد السومرية، حيث هناك تشابه بين مخططنا هذا وبين تخطيط قاعة الإله في المعبد السومري، والتي تسمى (السيلا والانتى سيلا)، ويبدو أن هذا الجزء من البيت رقم 10 هو لاستقبال ضيوف صاحب الدار البارزين.
لقد وجهت عناية فائقة لتزيين هذه الوحدة البنائية، حيث ظهرت جميع جدرانها مزخرفة بزخارف جصية بديعة الصنع والتصميم، بارتفاع حوالي المتر (انظر الشكل 20) ، وهذه الزخارف ذات أشكال بديعة لم نعثر على شبيهة لها فيما سبق من الزخارف التي كشفت في حفريات سامراء. قوام هذه الزخرفة أطر هندسية تؤلف عن طريق تقاطعها أطباقاً نجمية متصلة بعضها بالبعض الآخر اتصالاً جانبياً، وهذا الشكل يتكرر ويعمّ جميع الزخارف الجدارية في هذه الوحدة البنائية.
لقد نجح الفنان باختيار عناصر نباتية من أوراق وأنصاف أوراق نخيلية، وعناصر زهرية كاسية ثلاثية محورة عن الطبيعة لملئ هذه الأطر والأشكال الهندسية والنجمية البديعة (انظر الأشكال 20 - 21).
أما الأركان الخارجية والداخلية للمداخل والعضادات التي تؤطرها، فقد صمم الفنان لها زخرفة جميلة جداً قوامها أشكال معينة مقسمة من المنتصف إلى مثلثين متدابرین، ملئت جميعها بعناصر نباتية محورة قوامها أوراق وأنصاف أوراق نخيلية، وعروق نباتية مبسطة ، ملتوية ومحورة عن الطبيعة.
إن هذه الوحدة البنائية من البيت 10 هي أهم جزء من البيت، وإن نظام الدخول إلى البيت والممرّ والصحن والزخارف الوفيرة، كلها مؤشرات تشير إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لصاحب البيت رقم 10 .
الدار رقم 11 ، هي آخر دار بالنسبة إلى المساحة التي تم تنقيبها في هذه الحارة السكنية، يدخل إليه من نهاية الزقاق الخاص إلى جهة اليسار، ويؤدي المدخل إلى
ص: 58
دهليز ، يقود إلى غرفتين أمامهما رواق يطل على صحن البيت، وهناك اتصال بين هذا البيت وصحن البيت رقم 8 عن طريق الغرفة الواقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية للبيت رقم 11 ، وقد عثر على سرداب يقع في أسفل الغرفتين ج، د.
ومن الجدير بالذكر أن هذا السرداب هو إضافة لدور بنائي ثانٍ نفذ في الغرفة ج بعد البناء الأول، وقد ثبت ذلك لنا، حيث ظهر قبو السرداب نصف دائري، وهو يقص الزخارف الجدارية التي كانت في الأصل في الغرفة ج تزين جدرانها بارتفاع حوالي متر.
والزخارف الجدارية هنا تشبه تلك التي عثرنا عليها في البيت رقم 1 في هذه الحارة السكنية (انظر الشكل 15).
إن من أبرز مكتشفاتنا في هذا البيت هو قاعة مستطيلة، يبلغ طولها 12 متراً، وعرضها 3،5 متراً، ترتفع عن مستوى أرضية البيت حوالي 50 سم. وفي منتصف الجدار الجنوبي لهذا القاعة عثر على حنية تحفّ بها من كل جانب أطر مقعرة ومحدبة مرتبة بشكل جميل (انظر الشكل 22).
إن أرضية هذه القاعة ظهرت مسيعة بالجص ،الصلب، وتبدو نظيفة ومعتنى بها، وفي حالة جيدة من الحفظ.
إن حجم القاعة والحنية الموجهة باتجاه القبلة ترجح كون هذه القاعة مسجداً صغيراً خاصاً لأهل البيت، ربما كان الارتفاع في مستوى أرضيته عن مستوى أرضية باقي أقسام البيت هو تأكيداً لقدسية المكان والإشارة إلى أهميته وتمييزه عن باقي أجزاء البيت.
هذا وقد أيدت الحفريات وجود مثل هذه المصليات الخاصة في البيوت العراقية العباسية في سامراء، حيث كشف عن واحد ذي محراب جصي جميل في البيت رقم 2 ، الواقع بالقرب من مدق الطبل على بعد نحو نصف كيلو متر في جنوب بيت
ص: 59
الخليفة (1).
ولما كانت هذه البيوت غير بعيدة عن الجامع الكبير في سامراء، فإننا نرجح احتمال كون هذه المصليات ربما تكون خاصة لأهل البيت من النساء والأطفال ولأهل الدار بصورة عامة، في الأوقات التي لا تسمح بها الأحوال المناخية بالخروج من البيت للصلاة في الجامع الكبير في سامراء.
5 - الصيانة والتحري في جامع (أبي دلف):
جامع أبي دلف، هو جامع الجمعة الكبير لمدينة المتوكلية، الذي أمر ببنائه المتوكل في حدود سنة 245ه-، 845م .
يعتبر الجامع من وثائق القرن الثالث الهجري (9 ميلادي) المهمة في تاريخ العمارة الإسلامية في العراق، وأهميته هي نابعة من :
أولاً : كثرة ما تخلف من عناصره الأصلية، كالأقواس، والدعامات، والحليات المعمارية والمحراب، والمئذنة.
وثانياً: عدم تعرض بقايا هذا الجامع لأية صيانة أو تحوير أو إضافات على مدى العصور، أي منذ أن هُجر في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) وحتى النصف الثاني من القرن العشرين بعكس باقي الجوامع في بعض الأقطار الإسلامية، والتي تعود إلى نفس الفترة أو إلى قبلها أو بعدها، تعرضت إلى عمليات التجديد المستمر بحكم استمرار استعمالها للصلاة كما هو الحال في جامع عمرو في مصر، وجامعي الزيتونة والقيروان في تونس.
إن الضرر الوحيد الذي تعرض له هذا الجامع بعد هجره ينحصر في الأضرار التي سببتها العوامل الطبيعية، وبما أن الجامع مبني بالأجر الكبير الحجم
ص: 60
8× 28 × 28 سم، ولا يبعد كثيراً عن الضفة الشرقية لنهر دجلة، فقد أصبح - والحالة هذه - هدفاً سهلاً لسرّاق الآجر الذين نقلوا كثيراً منه بواسطة الحيوانات والوسائل النهرية، قبل صدور قانون حماية الآثار في العراق سنة 1924، وقد سبب هذا ضرراً راً بالغاً للكثير من جدران ودعامات وعقود هذا الجامع، ومع ذلك فالذي بقي يعتبر كافياً لإعطاء فكرة طيبة عن كافة تفاصيل هذا الجامع المهم.
لقد ألمحنا في ما سبق عن أن أول صيانة جرت لهذا الجامع كانت سنة 1944، والثانية في أواسط الخمسينات، أما الصيانة التي قمنا بها في صيف 1978، فتعتبر الحملة الثالثة التي تقوم بها المؤسسة العامة للآثار لصيانة جامع (أبي دلف).
لقد استمرت الصيانة في هذا الجامع بعد انتهاء أعمال الهيئة وحتى الوقت الحاضر، ضمن أعمال مشروع الإحياء الأثري لمدينتي سامراء والمتوكلية.
وفي هذا البحث سوف لا ندخل في تفاصيل دراسة هذا الجامع التخطيطية والمعمارية؛ لأن ما في المصادر الأجنبية والعربية يغني عن ذلك، حيث إن هذا الجامع قد درس من قبل الكثير من العلماء، منهم مس بيل(1)، وهرز فلد، وكريسويل، وجاءت دراسة الأستاذين بشير فرنسيس و محمود العينه جي - التي سبق ذكرها - مكملة لكافة الأبحاث السابقة؛ لما تمتاز به من دقة وشمولية (2).
لقد كان عملنا في هذا الجامع ينحصر برفع الأتربة والأنقاض من بين دعامات وأروقة الجامع، ومن بيت استراحة الخليفة خلف المحراب، وصيانة عقود ودعامات مؤخرة الجامع وبيت الصلاة فيه.
قامت الهيئة برفع كافة الأنقاض والأتربة من رواق المجنبة الشرقية والمجنبة الغربية، وكذلك تم تحري وكشف كافة قواعد الدعامات لصق سور اللبن الداخلي في الجهة الشمالية، وقد ظهرت مبنية بالآجر قياس 28 × 28 × 8 سم
ص: 61
والجص.
أنجزت الهيئة تنظيف ورفع كافة الأنقاض من مرافق بيت استراحة الخليفة، الواقع خلف محراب جامع أبي دلف، وظهرت كافة جدرانه وأرضياته وكانت قليلاً مرافقه مليئة بالأنقاض، مما ساعد على رسم مخطط تفصيلي له، وقد ظهر مطابقاً للمخطط السابق ما عدا بعض التغييرات البسيطة، والواقعة في القسم الجنوبي الشرقي منه (الأشكال 24 ، 25).
يدخل إلى هذا الدار من مدخلين: الأول: يقع في الزاوية الشمالية الشرقية، ويؤدي إلى دهليز يتصل مباشرة بواسطة مدخلين، الأول: يمضي بصورة مستقيمة إلى الدار الرئيسة التي تقع مباشرة خلف المحراب والثاني: ينعطف بالداخل إلى الجهة اليسرى، ويؤدي إلى دار مصمّمة على الطراز الحيري الكامل من الجهة الشمالية والحيري البسيط الخالي من الرواق من الناحية الجنوبية.
أما المدخل الثاني: فيقع في جدار القبلة إلى الجهة اليسرى بالنسبة إلى الواقف أمام محراب الجامع، ويؤدي إلى الصحن المركزي للبيت، وهو صحن بديع مبلط بالآجر المربع ، تطل عليه أربعة أواوين، تحفّ بها من كل جانب الغرف والقاعات، وهذا التخطيط يعرف بالتخطيط المتعامد حيث يسوده التماثل والتناظر، وهو معروف في العمارة العراقية قبل الإسلام (انظر الشكل 26).
أما الصيانة فقد بدأت في أول الأمر في القسم الشمالي من الجامع، أو ما يعرف بمؤخرة الجامع، حيث تعرضت العقود والدعامات في هذا القسم من الجامع إلى تصدعات وتخريبات كثيرة. وقد نجحنا في صيانة معظم هذه الأجزاء بواسطة الآجر والجص. وقد حرصنا على استعمال نفس مواصفات الآجر القديم؛ للحصول على نتائج قريبة للمواصفات العباسية القديمة.
لقد كانت خطتنا في العمل هو الإبقاء والمحافظة على الأجزاء القديمة بقدر
ص: 62
الإمكان.
بعد الانتهاء من صيانة مؤخرة الجامع نقلنا العمل بتركيز إلى بيت الصلاة، حيث تمكنا من صيانة معظم دعامات هذا الجزء.
لقد استعملنا في إعادة بعض عقود الجامع طريقة القوالب الجصية، حيث تم عمل القالب الجصي بواسطة القصب على الأرض بنفس الشكل والمقاسات الأصلية، ثم رفع بعد تهيئة الدعامات وصيانة الأفاريز التي تحته، وبعد رفع وتثبيت القالب في كلا الجهتين تبدأ العقادة من الأسفل إلى الأعلى بطريقة الحل والشد بخطوط متوازية جنباً إلى جنب، ومن كلا الجانبين إلى أن تلتقي العقادة في الوسط.
قامت الهيئة أيضاً بتركيز العمل على صيانة حليات الجامع المطلّة على الصحن، وهي بهيئة مشكاوات مستطيلة الشكل في أعالي الدعامات المطلّة على صحن الجامع، تحفّ بها أطر مقعرة ومحدبة.
انتهت أعمال هيئتنا في أواخر شهر آذار 1982 ، ولا زال العمل متواصلاً في صيانة هذا الجامع المهم.
القطع الأثرية المكتشفة:
لقد كانت حصيلة أعمالنا في ما يخص القطع الأثرية المكتشفة هي العثور على الكثير من القطع الفخارية والزجاجية والمعدنية، أما القطع الفخارية فقد تبين أنها تنتمي إلى ثمانية أساليب صناعية:
1 - فخار الباربوتين (الشكل 34) ، وهو الفخار ذو الزخارف الملصقة قبل شيّ الإناء.
2 - الفخار المحرّز وهو من النوع البسيط.
3- الفخار المزجج بلون موحد عادة اللون الأزرق.
ص: 63
4 - الفخار المبقع أو ما يسمى ب_ Splash Pottery (انظر الشكل 40، 41 ) .
5 - الفخار المحرّز تحت الدهان شكل 41 .
6- الفخار ذو البريق المعدني (الأشكال 40، 41).
7 - الفخار الرقيق جداً.
8 - الفخار السمج والغفل من أي نقش أو لون.
وقد تم عثورنا على سلطانية جميلة متوسطة الحجم ذات ثلاثة ألوان، زخارفها بشكل أنطقة تشكل أشكالاً شبيهة بالمثلثات (انظر الشكل 37)، وكذلك على بعض المسارج الصفر (انظر الشكل 33،32، اما الزجاج فقد ظهر مطحوناً ومكسراً (الشكل 29 ، 30).
والشكل رقم 29 ، 30 يعرض بعض النماذج من القناني الزجاجية التي ظهرت في حفريات الحارة السكنية.
أما المعادن فأبرز ما اكتشفنا هو الجرة المعدنية التي ذكرناها سابقاً، وآلة التحزيز (انظر الشكل 31).
وبصورة عامة فإن كافة مكتشفاتنا الأثرية هي شبيهة شبهاً كبيراً بما تم اكتشافه حفريات عام 1936 والتي استمرت حتى عام 1939 والتي نشرت صورها في كتاب حفريات سامراء الجزء الثاني، وتجنباً للتكرار فإننا سنكتفي بالنماذج التي سوف نقدمها مع هذا البحث.
وفيما يلي النماذج المهمة التي تم اكتشافها خلال الحفريات:
1 - الشكل 27 يعرض كرسياً أو مقعداً فخارياً صغيراً مربع الشكل له أربعة أرجل وعلى إحدى واجهاته زخرفة محززة على الأرجل، وبقايا قرون ربما تعود إلى رأس وعل بري أو كبش على الحافة العليا. الارتفاع 15 سم والعرض 19 سم .
ص: 64
إن هذا الكرسي مجوف في القسم الأعلى (القاعدة) ، فلربما كان يستعمل كمقعد لجرّة فخارية رقيقة ذات قاعدة كروية (انظر الشكل 28).
2 - مجموعة من القناني الزجاجية الصغيرة توجد عادة في الحفريات بشكل مهشم، وفي حالات نادرة بشكل كامل (الشكل 29، 30) اللون السائد لهذه القناني هو اللون الأبيض، وتوجد بعض القناني باللون الأخضر الفاتح واللون الأزرق الفاتح. أما استعمالات هذه القناني فربما كانت للعقاقير والعطور، وتكون في هذه الحالة سداداتها من الشمع، أما القطعة (أ) في الشكل 30 فتمثل عنقاً وفوهة، وتبدو أنها تعود الجرّة زجاجية كبيرة.
3- جرّة صغيرة من البرونز كروية الشكل، وذات رقبة قصيرة وغطاء دائري، وهناك ثلاثة ثقوب في قسمها الأسفل قياساتها على الشكل التالي:
الارتفاع 9،2 سم ، قطر البدن 8 سم ، قطر الفوهة 5 سم. عثر على هذه الجرة في الورشة التي تعود للبيت رقم 10 بالقرب من المصهر. نرجح كون هذه الجرة لها علاقة صناعية من نوع معين، كذلك عثر على آلة صغيرة مسننة من البرونز، تصلح لتحزيز الفخار في نفس المكان وبالقرب من الجرّة (انظر الشكل 31).
4 - شكل رقم 32 يعرض فخاريات مزججة وغير مزججة، (الشكل أ) يمثل رقبة جرّة ذات طينة رقيقة جداً مائلة إلى اللون الأصفر الفاتح، عليها حزوز في الحافة العليا (انظر الشكل 33) أما القطعة ب فتمثل جزءاً من بدن جرة كروية ذات زخارف محززة بأشكال دائرية أما الشكلان ج، د، فهما لمسرجتين صغيرتين مزججتين باللون الأزرق الغامق ذات مقاييس متقاربة : الطول 10 سم، القطر 7،5 سم الارتفاع 2،6 سم القطعة (ه_) تمثل قدحاً صغيراً مزججاً باللون الأخضر الفاتح، والبني الفاتح، والأصفر الفاتح ارتفاعه 5 و4 سم، قطر الفوهة 4،3 سم، قطر القاعدة 3،2.
ص: 65
أما القطعة ( و ) فهي مسرجة فخارية غير مزججة عليها حزوز خزفية في قسمها العلوي.
5 - الشكل رقم 34 يمثل بعض القطع من فخار الباربوتين، قوام زخرفته دوائر وأشكال نجمية، وأوراد ذات أربعة فصوص، وكذلك أشكال متعرجة، انظر الشكل 35، وهناك قطعة صغيرة تمثل الجزء الخلفي الأسفل من حيوان، ربما كان يمثل حيواناً مفترساً كالأسد أو النمر استناداً إلى مخالب الأرجل وزخرفة الدوائر التي تذكر بجلد النمر المرقطة . الشكل 36 يعرض نماذج أخر من هذا الفخار.
6 - الشكل 37 يمثل سلطانية جميلة الشكل، وجدت مكسرة، وصلّحت في نختبر المؤسسة العامة للآثار ، وهي مزججة ومزخرفة بأنطقة مثلثات، تلتقي بالرؤوس عند نقطة في مركز الإناء، أما الألوان فهي بنية وخضراء وصفراء وبيضاء. الارتفاع 6،5 سم، والقطر 23،5 سم، (الشكل 38) يمثل رسوماً هندسية لبعض الأواني الفخارية المزججة المكتشفة خلال التنقيبات.
7- الشكل 39 قطعة فخارية مزججة باللون الأبيض تعود بالأصل إلى إناء دائري الشكل عليها نص كتابي بالخط الكوفي، لم نستطع قراءته في الوقت الحاضر، وربما كان جزءاً من نص ديني.
8- الشكلان 40، 41 يعرضان نماذج من قطع خزفية ذات ألوان وأشكال وزخارف منوعة.
9 - الشكل 42 يعرض ثلاث جرار بديعة الصنع، خالية من الزخرفة والتزجيج ما عدا بعض الحزوز الدائرية البسيطة، الأولى من اليمين كروية الشكل، وذات فوهة صغيرة وضيقة تعرف هذه الجرّة برمانة المز ، وكانت تستعمل لشرب الخمور، وكان الخمر يمرّ من فوهتها الصغيرة مزاً.
ولا شك في أن أشكال الفوهة التي تشبه (الحلمة) كان يساعد على ذلك
ص: 66
مساعدة تامة (1).
قياساتها: الارتفاع 5 و 7 سم، قطر البدن 5 و 7سم. الجرة التي في الوسط وجدت كاملة وبحالة جيدة (الشكل 43 أ) ، ارتفاعها 24 سم، قطر الفوهة 8و8 سم.
أما الجرة الثالثة فهي تشبه السابقة من حيث الشكل وتختلف عنها في القياس، فالارتفاع 15سم، وقطر الفوهة 9،5 سم.
10 - الشكل 44 يعرض نماذج من القطع المعدنية من البرونز والنحاس تمثل حلياً ومقابض ومروداً وكلاباً وآلة مسننة سبق الإشارة إليها.
11 - الشكل 45 يمثل نماذج من الطابوق المزجج بلونين: الأبيض والبني الداكن، قوام زخرفته العروق النباتية الملتوية (الشكل 46)، والأشكال التجريدية المتنوعة.
12 - الشكل 9 يعرض قطعة الخشب الصاج التي تم العثور عليها بالقرب من مدخل المنارة في البناية المعروفة بقبر أبي دلف، في المتوكلية، يبلغ طولها 153 سم، القطر في الوسط 4،7 سم، السمك عند النهايتين 6،5 سم، ويبدو من شكلها بانها ربما كانت تشكل جزءاً من درج أو سياج الشرفة.
13 - الشكل 47 يعرض بعض القطع المعمولة من المرمر الأبيض، القطعتان العلويتان تعودان إلى أقداح، أما القطعة الصغيرة فهي غطاء جميل لعلبة صغيرة أنيقة، والقطعة التي على يسارها ربما كانت تشمل جزءاً من سياج شرفة مرمرية.
ص: 67
المراجع العربية
1 - حفريات سامراء 1936 - 1939 ، جزءان نشر مديرية الآثار العامة (بغداد 1940)
2 - العينه جي، «جامع أبي دلف في سامراء»، سومر، المجلد 3 (1947)، ص 60 - 76 .
3- المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد)، (القاهرة 1965) ، الجزء الرابع.
4- سوسة أحمد ري سامراء في عهد الخلافة العباسية، جزءان، (بغداد 1948 ).
المصادر الأجنبية
1 - Bell، G. L. Amurath to Amurath (London 1911).
2- Creswell A. A short Account of Early Muslim Architec- ture (Beurut, 1968).
3- Huzbeld, E. Archaologishe Reise in Euphrat and Tigris - Gebiet (Berlin 1911-20).
4– al – janabi, T. Studies in Iraq Medieval Architecture. Umpublished PH.D. thesis (Edinburgh, 1975).
ص: 68
الصورة

ص: 69
الصورة
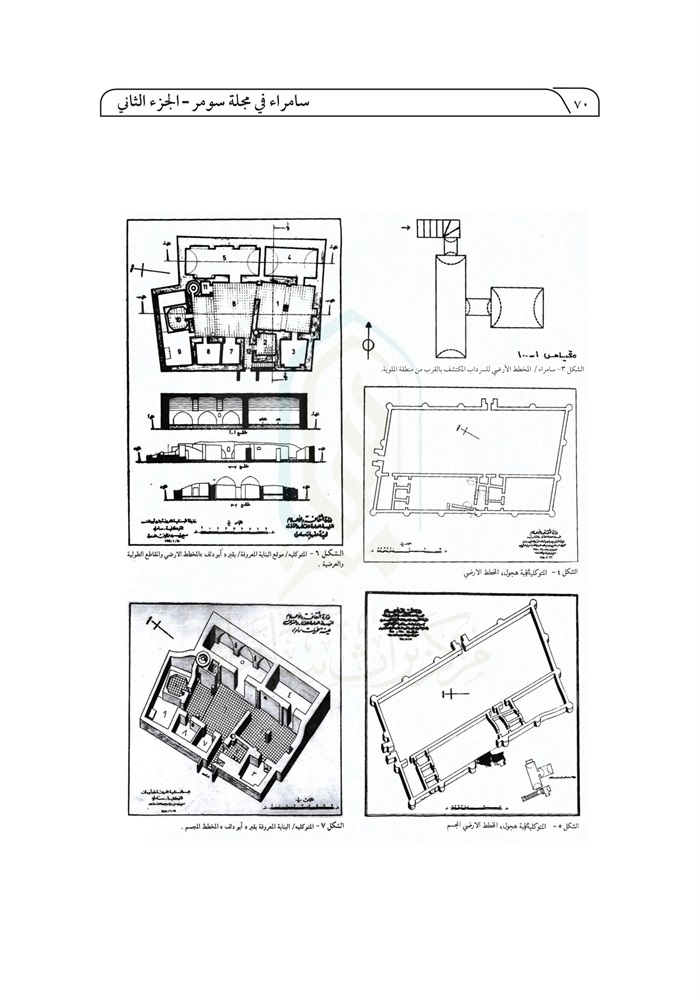
ص: 70
الصورة
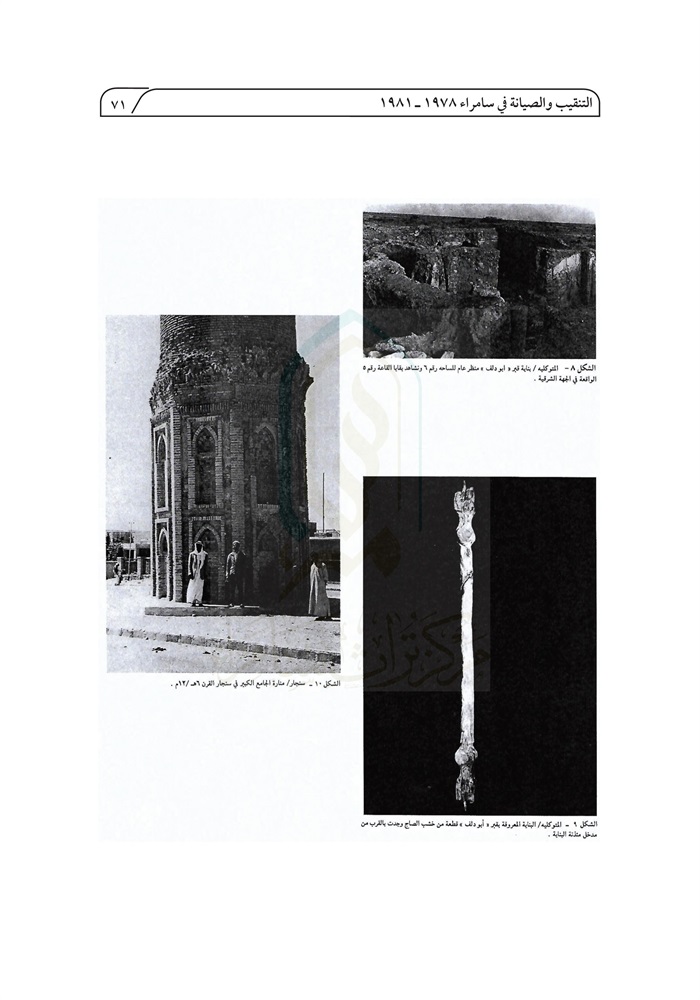
ص: 71
الصورة
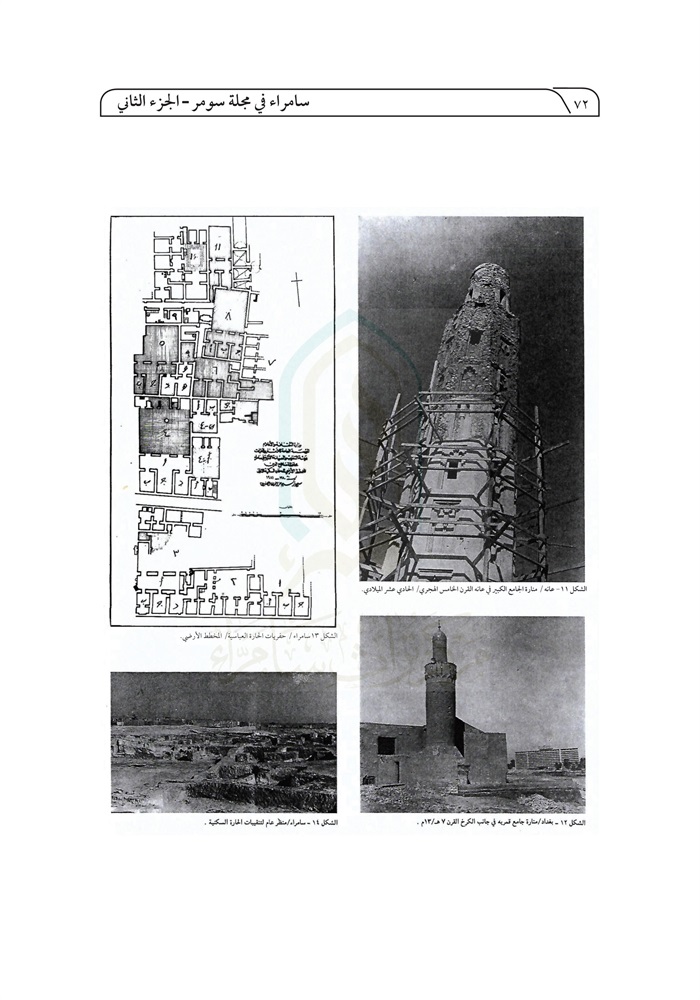
ص: 72
الصورة
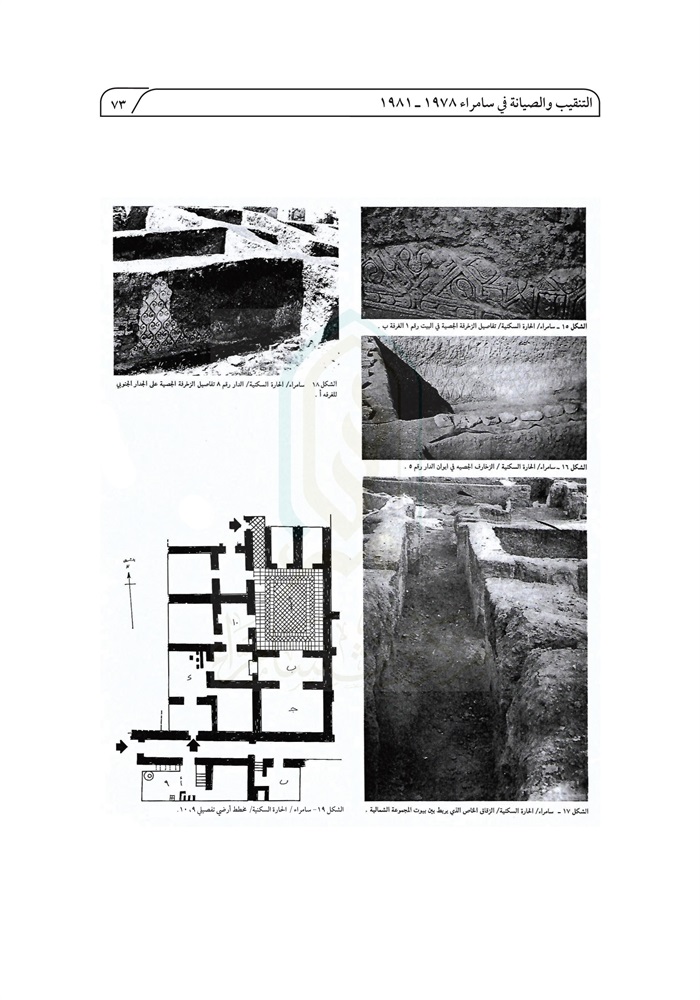
ص: 73
الصورة

ص: 74
الصورة

ص: 75
الصورة
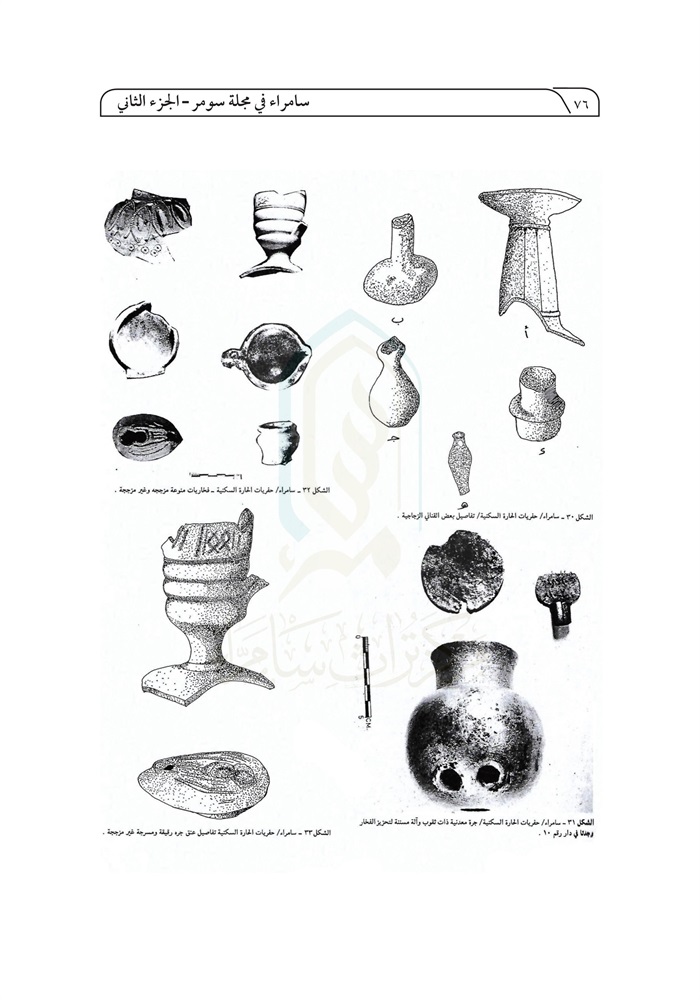
ص: 76
الصورة

ص: 77
الصورة
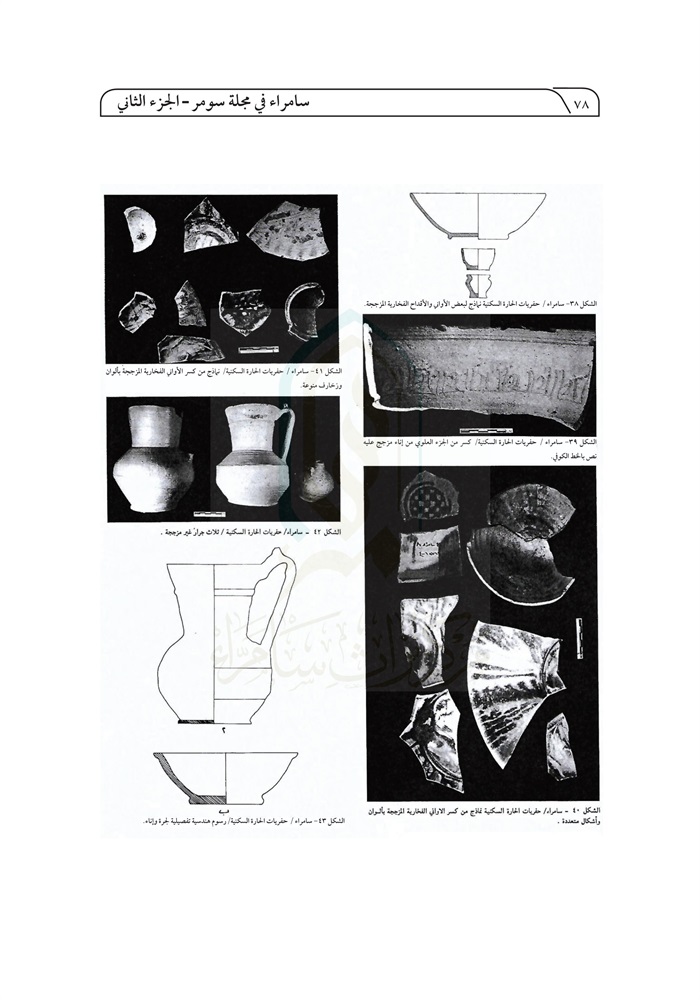
ص: 78
ص: 79
ص: 80
المجلد الثامن والثلاثون سنة 1982
دراسة أولية في تاريخه، وتخطيطه، وعمارته والأعمال التي أجريت فيه خلال الفترة من حزيران 1981 لغاية كانون الأول 1982.
خالد خليل حمودي
باحث علمي
مقدمة:
أطلق على هذا القصر اسم (دار الخليفة)، حيث أمر ببنائه الخليفة العباسي المعتصم بالله، وسمي أيضاً (دار العامة)؛ إذ كان الخليفة يجلس فيه يوم الاثنين من كل أسبوع للنظر في أمور الرعية(1)، وكان يسمى كذلك (الجوسق)، و(الجوسق الخاقاني)، نسبة إلى أحد أتباع الخليفة المعتصم المسمّى خاقان عرطوج، أبا الفتح ابن خاقان الذي أمره المعتصم ببناء هذا القصر (2).
شيد القصر من قبل الخليفة المعتصم ، الذي نقل مركز الخلافة العباسية من مدينة بغداد إلى عاصمته الجديدة (سامراء) في سنة 221 هجرية (836 ميلادية)، حيث أقام فيه طيلة فترة حكمه حتى وفاته سنة 227 هجرية (842 ميلادية) ودفن فيه (3). وهناك إشارات ومعلومات قليلة عن السكنى في هذا القصر لفترات متفاوتة
ص: 81
ومتقطعة، أمدتنا بها المراجع العربية بعد خلافة المعتصم. ففي عهد الخليفة المتوكل على الله (232 - 247 هجرية / 846-861 ميلادية أضيف إلى القصر بناء(1)، وأقام هذا الخليفة فيه في بعض سني حكمه، ويبدو أن ذلك كان لفترة قصيرة (2)، كما نزل فيه ابنه وولي عهده محمد المنتصر (3) ، وأقام فيه لفترة من الوقت أثناء خلافته حتى توفي ودفن فيه سنة 248 هجرية (862 ميلادية) (4).
وبويع فيه للخلافة المستعين بالله سنة 248 هجرية أيضاً، وأقام فيه أحياناً(5)، وجلس فيه المعتز أثناء خلافته (252 - 1255 هجرية / 866 - 869 ميلادية ) (6) ، أقام فيه الخليفة المهتدي عاماً كاملاً حتى مقتله سنة 256 هجرية (870 ميلادية) (7)، وبعد ذلك جاء إلى الخلافة (المعتمد)، فأقام في هذا القصر فترة من الزمن، ثم بنى في الجانب الغربي من نهر دجلة قصره المعروف بالمعشوق، وانتقل إليه وسكنه حتى سنة 279 هجرية (892 ميلادية)، حيث حدثت اضطرابات، فترك سامراء وأعاد مركز الخلافة إلى بغداد (8) .
ص: 82
إن هذا القصر يعتبر من الأبنية المهمة في مدينة سامراء ليس فقط من الناحية السياسية، حيث كان مقراً للخلافة العباسية، وإن أحداثاً سياسية مهمة جرت فيه أو بالقرب منه (1)، وإنه استمر يلعب دوراً مهما لفترة طويلة، وإنما له أهمية أيضاً من ناحية اتساع مساحته ، وشكله التخطيطي، وعناصره المعمارية، وما فيه من زخارف جدارية.
لم تتناول المراجع العربية وصف هذا القصر بشكل مفصل وواضح، إلا أن عدداً من الباحثين وعلماء الآثار الأجانب أدركوا بقاياه في مطلع القرن الحالي حيث كان أحسن حالاً مما عليه اليوم، ومنهم المهندس الفرنسي هنري فيوله (H. violet) الذي قام ببعض التحريات والتنقيبات الاستكشافية فيه لفترات متقطعة بين سنة (1911-1907 ميلادية) (2)، ووضع رسما تخيلياً للقصر. وبعد ذلك قامت بعثة ألمانية برئاسة الأستاذ هيرتسفلد (Herzfeld) بزيارة العراق والتنقيب في أطلال هذا القصر ، واستمرت في عملها حتى نشوب الحرب العالمية الأولى، فكشفت كثيراً من معالمه المندثرة ووضعت له رسماً تخطيطياً، ونشرت نتائج أعمالها في سامراء عموماً في عدة مجلدات (3) .
وبعد أن أولت دائرة الآثار العراقية اهتمامها بمدينة سامراء وآثارها قامت بأعمال تنقيب وصيانة موسمية في القصر، ابتدأت منذ سنة (1936) واستمرت لفترات متقطعة حتى سنة (1981)، حيث ظهر إلى حيز التنفيذ مشروع واسع
ص: 83
لتطوير مدينتي سامراء والمتوكلية الأثريتين من أجل إحياء المعالم الأثرية وصيانة الآثار الشاخصة، حيث كان لقصر الخليفة المعتصم نصيب وافر في أعمال التنقيب ،والصيانة، وما زالت الأعمال جارية فيه حتى الوقت الحاضر (1) .
الموقع:
يقع قصر الخليفة على الضفة الشرقية من نهر دجلة، وكانت مساحة الأرض الواقعة بينه وبين النهر تمتد في عرضها إلى مسافة ستة كيلو مترات تقريباً، لكنها اليوم أصبحت مغمورة بالمياه حسب إقامة مشروع سد الثرثار على دجلة. وكان هذا القصر يقع على أحد الشوارع المهمة في سامراء العباسية، وهو شارع الخليج الممتد بمحاذاة نهر دجلة. حيث كان موقعه على هضبة يصل ارتفاعها نحو (17) متراً بالنسبة إلى الأرض السهلية المجاورة. وأطلال القصر تبعد اليوم عن المسجد الجامع والملوية بمسافة (2500) متراً تقريباً من الجهة الشمالية.
إن اختيار موقع القصر بعيداً عن المسجد الجامع ظاهرة غير مألوفة في المدن الإسلامية المشيدة قبل سامراء، كالبصرة والكوفة وواسط وبغداد التي شيدت فيها دار الإمارة وقصر الخلافة بجوار المسجد الجامع (2) ، على أن بوادر بناء قصور الخلافة بعيداً عن المسجد الجامع قد ظهرت في مدينة بغداد قبل الانتقال إلى العاصمة الجديدة سامراء. ويبدو أن ذلك البعد كان مقصوداً لعوامل عديدة في مدينة سامراء بالذات، منها ما هو متعلق بالمساحة الواسعة المخصصة للقصر، والتي يؤدي اقتطاعها من
ص: 84
وسط المدينة إلى حرمان عامة الناس من بناء أكبر مجموعة من الدور السكنية قرب المسجد الجامع، ومنها الابتعاد عن الأسواق ودور العامة لتوفير حرية أكثر للخليفة وحاشيته وقضاء الوقت في الألعاب والتسلية واللهو، وقد يكون البعد بقصد إضفاء نوع من الأبهة على موكب الخليفة أثناء مروره بالشوارع عند ذهابه للصلاة في المسجد الجامع في المناسبات والأعياد.
أما بالنسبة إلى طبيعة الأرض التي شيد عليها القصر، فإن المراجع العربية تذكر أنها كانت صحراء لا عمارة فيها سوى دير للنصارى(1)، وتكثر فيها الأخاديد والشقوق والمناطق الحصوية (2). ونلاحظ الأرض ذات تربة جصية في الغالب وأحياناً تكون التربة ممزوجة مع قطع الحصى المختلفة التي تؤلف طبقة عليا سطحية يتراوح ارتفاعها بين (50-150) سنتمتراً، وتحتها توجد طبقة من حجارة كأنها قطعة واحدة ارتفاعها بين (2-5) متراً، يلي ذلك بأسفل منها طبقة من الرمل وقطع الحصى الصغيرة الممزوجة معه. ويبدو أن طبيعة الأرض هذه قد ساعدت على بناء وحفر الأنفاق والسراديب والأقبية تحت سطح الأرض، وكذلك في توفير قنوات ومجار للمياه وتصريفها، وهو ما نراه شائعاً في سامراء.
المساحة:
إن أطلال هذا القصر الكبير وبقايا أبنيته وملحقاته تنتشر على مساحة شاسعة تقدر بأكثر من مليون متراً مربعاً.
تشير المراجع العربية إلى مشاركة أكثر من ألف رجل في وضع أساس هذا القصر (3) ، وكانت فيه أقسام عديدة ومرافق سكنية كثيرة، ففيه مجلس الخليفة ودار الاجتماعات وقاعات الاستقبال والتشريفات، وفيه بيت المال (الخزائن العامة
ص: 85
والخاصة وبعض الدواوين، وخزانة السلاح، وثكنات للجند، وساحات للفروسية وسباق الخيل، وأقيم فيه سجن خاص للأمراء وكبار القادة(1)، وكان من الاتساع بحيث بنى المعتصم فيه داراً لإحدى جواريه (2)، وبنى المتوكل قصراً فيه(3)، وبنى المعتز بيتاً في صحنه (4) ، وأقيمت فيه دور لبعض القادة.
وكانت له عدة مداخل(5) وتذكر بعض الحوادث التاريخية اجتماع أربعة آلاف شخص من الموالي فيه (6)، هذا وكان السهل الممتد بينه وبين نهر دجلة يضم بركة وبساتين تابعة للقصر (7).
لقد أوضحت نتائج التحريات والتنقيبات في هذا القصر والمخطط الموضوع عنه من قبل بعثة التنقيب الألمانية برئاسة هرتسفلد أنه حدثت فيه عدة إضافات وزيادات على البناء الأصلي. ولعل ذلك يوضح لنا سبب الاتساع الكبير الذي تميز به هذا القصر، كما أنه يفسر لنا ظهور عدة تسميات تدل على هذا القصر ورد ذكرها في المراجع العربية.
التخطيط:
روعي في التخطيط العام للقصر أن يكون متناسباً مع موقعه القريب من ضفة
ص: 86
النهر، وتم اختيار بقعة من الأرض تتلاءم مع المساحة الواسعة للقصر ومع تخطيطه المتجه نحو الجهة الغربية تقريباً، والجدير بالذكر أن اتجاه المحور العام للتخطيط نحو الغرب ظاهرة جديدة في العمارة الإسلامية عموماً؛ لأن السائد فيها اتجاه المحور نحو جهة القبلة، وهي بالنسبة إلى العراق الجهة الجنوبية الغربية.
إن حالة القصر الحالية واندثار بعض معالمه لا تساعد على وضع مخطط دقيق متكامل له في الوقت الحاضر إلا بعد استكمال التنقيبات فيه، والتي تحتاج إلى جهود كبيرة وزمن غير يسير (1)، على أن الأستاذ هيرتسفلد وضع مخططاً عنه يمكن الاعتماد عليه في كثير من الأحيان، حيث كان ممكنناً تتبع معالم القصر وتخطيطه خلال الفترة التي جرت فيها التنقيبات في هذا القصر قبيل الحرب العالمية الأولى سنة (1914)؛ لذلك أصبح من الواجب علينا الاستعانة بذلك المخطط والوصف الذي كتبه هير تسفلد عنه(2).
يبدو لنا من خلال إلقاء نظرة عامة على هذا القصر ومخططه أن أبعاده الخارجية مترامية الأطراف وغير واضحة تماماً، وأن أسواراً مختلفة تحيط ببعض أجنحته وأقسامه، وأن المدخل الرئيس للقصر هو باب العامة الباقية آثاره إلى اليوم، على أن الروايات التاريخية تشير إلى وجود أكثر من مدخل واحد للقصر.
يتكون مدخل القصر المسمى باب العامة من واجهة كبيرة قوامها ثلاثة عقود مدببة، أوسطها أكبرها حجماً وارتفاعاً، ويتقدم إيوان كبير له قبو مدبب
ص: 87
يشغل مساحة مستطيلة الشكل، طولها من الشرق إلى الغرب (17,50) متراً، وعرضها من الشمال إلى الجنوب حوالي ثمانية أمتار، أما ارتفاع العقد فيصل إلى حوالي (12) متراً، وهذا الإيوان الأوسط مفتوح من الجهة الغربية، بينما يوجد في الجهة الشرقية منه باب صغير عرض فتحته (3٫80) متراً، وارتفاعه سبعة أمتار تقريباً، وهذا الباب يفضي إلى منطقة مستطيلة واسعة عرضها حوالي (16) متراً، وهي تمتد من الشرق إلى الغرب ومن المحتمل أن يكون لها سقف بشكل قبو طويل يتألف من عدة أقسام، أو أن السقف يتكون من عدة أقبية مجاورة تمتد في اتجاهها من الشمال إلى الجنوب، أي بصورة مستعرضة تفصلها بعضها عن بعض عقود ضخمة، بعد ذلك توجد ساحة أو فضاء مربع الشكل حيث توجد في الوسط نافورة، وعلى الجوانب حجرات للزوار. وبعد اجتياز ذلك توجد حجرات ورحبة مستطيلة صغيرة تؤدي إلى القاعة التي فيها مجلس الخليفة، وعليها قبة تقوم فوق مساحة مربعة الشكل، في کل ركن من أركانها الأربعة وحدات سكنية صغيرة مفصولة عن بعضها بأروقة أربعة تمتد بصورة عمودية على أضلاع المساحة المربعة المذكورة.
أما بالنسبة إلى العقدين الواقعين على طرفي الإيوان الكبير الأوسط السالف الذكر فإنهما يتوجان واجهة دخلة كبيرة ، اتساع فتحتها ( 4,50) متر، وعمقها (4,10) متر، لها سقف بشكل نصف قبة كروية. ويوجد في الجدار الشرقي لكل منهما باب عرضه (1,75) متر وارتفاعه (50, 5) متر ويعلوه عقد مدبب. يؤدي هذا الباب إلى قاعة كبيرة ذات قبو مرتفع على غرار قبو الإيوان الأوسط، مساحتها مستطيلة الشكل طولها (11,65) متراً، وعرضها (4) أمتار، وهي متصلة مع الحجرات المجاورة لها. و من المعتقد أن الباب الواقع في شمال الإيوان المدخل الرئيس، كان مخصصاً لدخول الضيوف الزوار، حيث يفضي إلى قاعات وحجرات الاستراحة، بينما الباب الواقع في جنوب إيوان المدخل كان مخصصاً لدخول الحريم، حيث يوجد الجناح الخاص بالحريم في الجهة الجنوبية.
ص: 88
يؤلف هذا القسم قلب القصر ومركزه الرئيس، وهو يطل على الساحة الكبرى للقصر بواجهة ضخمة طولها حوالي (20 ,43) متراً وعرضها - وهو بروزها نحو الساحة - (13) متراً تقريباً.
وتوجد في هذه الواجهة خمسة مداخل مفتوحة على ساحة القصر، وهكذا يبلغ طول هذا القسم من باب العامة حتى الساحة الكبرى للقصر حوالي (185) متراً.
وتجدر الإشارة إلى أن جناح (الحريم) الواقع في الجهة الجنوبية من هذا القسم يشتمل على العديد من الوحدات السكنية المزودة بالحمامات ومجاري المياه، حيث عثر على بقاياها.
أما في الجهة الشمالية فتوجد آثار نافورة تتوسط ساحة صغيرة وعدد من الوحدات السكنية.
وأهم ما يلاحظ فيها وجود مساحة مربعة طول ضلعها (180) متراً، محاطة بسور ضخم يتصل مع سور ساحة القصر، يتوسطها منخفض كبير بشكل بركة قطرها حوالي (70) متراً، تحيط بها أبنية وحجرات كثيرة تبدو بارزة إلى الداخل عند الأركان الأربعة. ومن المحتمل أن يكون هذا الموضع بركة تأخذ مياهها من قناة (كهريز) في أسفلها، لكننا نرجح اتخاذها موضعاً أو مسرحاً للألعاب؛ بسبب تخطيطها وعمارتها وشكلها العام، ولوجود بركة قريبة منها أمام باب العامة.
وإلى الشمال من هذا الموضع يوجد بناء يرجح أن يكون بيت المال، أو ما يعرف اليوم بالخزانة العامة للدولة، وهو يشغل مساحة مستطيلة الشكل تحيط بها أسوار ضخمة. أما في الزاوية الشمالية الغربية فتقع ثكنات الجند والفرسان من أتباع الخليفة وحاشيته، وفيه من الحجرات ما ذكر أنها حوالي ( ستمائة)، تتسع لإيواء ثلاثين ألف جندي.
وساحة القصر كبيرة جداً، وذات شكل مستطيل منتظم ممتد من الشرق إلى
ص: 89
الغرب، حيث يصل طولها إلى حوالي (345) متراً وعرضها (192) متراً تقريباً، ولها سور من اللبن ضخم مدعم بالأبراج المستطيلة الشكل، حيث ما تزال بعض أجزائه باقية إلى اليوم.
ويخترق الساحة من الشمال إلى الجنوب منخفض كبير له قبو مبني بالآجر عند بدايته وعند نهايته، وله سلالم أحدها يمرّ تحت السور الشمالي لهذه الساحة، والآخر يؤدي إلى القسم الغربي من الساحة، والثالث يؤدي إلى القسم الشرقي من الساحة، كما يتفرع منه فرع صغير يتجه نحو الجنوب له قبو وأرضية من الآجر الجيد. ولا يمكننا التكهن بطبيعة هذا المنخفض ، فربما يكون نهراً، ومحتمل أن يكون نفقاً تحت سطح الأرض يربط القسمين الواقعين في شمال الساحة وجنوبها، والبتّ في ذلك يتطلب استكمال أعمال التنقيب في هذا القصر وتتبع سير هذا المنخفض من جهة الجنوب. هذا وكان عرض القبو الكبير السالف الذكر (75 3٫) متر، وارتفاعه حوالي ( 2/60) متراً.
السرداب (هاوية السباع):
على نفس المحور الممتد من مدخل القصر (باب العامة)، وفي خارج السور الشرقي للساحة الكبرى للقصر، توجد منطقة منخفضة عميقة بشكل حفرة مربعة طول ضلعها (21) متراً وعمقها الحالي (8) أمتار تقريباً، وفي كل جانب من جوانبها حفرت أواوين ثلاثة داخل الأرض بطول (6,75) متراً، لكن عرضها - وهو اتساع فتحتها - مختلف، فالإيوان الأوسط أكبرها ، عرضه (3,10) متراً، في حين يبلغ عرض الإيوانين الواقعين على طرفيه - وهما متساويان تقريباً - حوالي (2٫60) متراً. وهذه الأواوين مرتبطة مع بعضها بواسطة بابين مفتوحين في جداري الإيوان الأوسط. ولوحظ تقسيم أحد الإيوانين الصغيرين إلى قسمين بينهما باب. وكل مجموعة من هذه الأواوين الموجودة في إحدى الجهات ترتبط مع المجموعة المجاورة لها في الجهة
ص: 90
القريبة منها بواسطة ممر يتراوح اتساعه بين (1,40 - 1,55) متراً، ويتخذ الممرّ شكلاً منحرفاً بزاوية قائمة يوازي ركن المساحة المربعة. أما النزول إلى داخل هذه المنطقة فيتم بواسطة سلّمين كل منهما يتكون من حوالي (40) درجة، أحدهما يقع في الجهة الشمالية، والآخر في الجهة الغربية، وهذا الأخير يؤدي إلى ممر صغير فيه مداخل تفضي إلى ممرين يرتبطان مع أواوين الجهة الجنوبية وإلى فتحة على الساحة الوسطية، وإلى ممر يؤدي إلى أواوين الجهة الغربية.
أما القسم القسم الأوسط من هذه المنطقة المنخفضة فيظهر بشكل ساحة مربعة الشكل يبدو أنها كانت أوطأ في مستواها بالنسبة إلى ما يحيط بها، ويوجد نفق بشكل قبو صغير تحت مستوى أرضية الإيوان الأوسط في الجهة الجنوبية يرجح كونه قناة تزود نافورة أو حوض ماء في وسط الساحة المذكورة.
كانت الأقسام العليا من هذه المنطقة تتألف من العديد من الحجرات المستطيلة المتجاورة التي تحيط بالمنطقة المنخفضة من جهاتها الأربع ، ويبدو أن هذه البناية كانت متصلة مع مساحة القصر بمدخل في السور الشرقي للساحة.
وتجدر الإشارة إلى أن البناء في هذه المنطقة فيه ما يدل على الاهتمام والعناية سواء كان ذلك بطريقة الحفر وتغليف الجوانب بالآجر وتغطيتها بطبقة من الجص، وإبراز إشكال العقود، ووجود تبليط جيد من الآجر، وربما كان بعضه من المرمر حيث عثر على كسرات منه. كما تم اكتشاف زخارف جصية جدارية في الإيوان الأوسط في كل من الجهتين الشرقية والجنوبية. ويذكر الأستاذ هرتسفلد أنه عثر على رسوم زخرفية ملونة في مدخل أحد السلمين. ولما كانت تسمية المنطقة بالهاوية والبركة والحير لا تنطبق عليها من الناحية اللغوية والعلمية والعملية، ونرى أنها غير دقيقة، لذا نرجح اتخاذ هذا المكان سرداباً للراحة، وربما للتسلية(1).
ص: 91
ساحة الفروسية:
توجد خلف المنطقة المعروفة بهاوية السباع ساحة مربعة الشكل أيضاً، تكاد تتساوى في مساحتها معها، وتبدو أرضيتها بمستوى أوطأ مما يجاورها، وخلف هذه الساحة المربعة توجد ساحة واسعة مستطيلة منتظمة الشكل تمتد من الشمال إلى الجنوب مع وجود ميل قليل في اتجاهها بالنسبة لأبنية القصر الأخرى، ويبلغ طولها (530) متراً، وعرضها حوالي (65) متراً. وفي وسط الضلع الشرقي منها توجد بناية للجلوس ومشاهدة سباق الخيل وألعاب الفروسية التي تجري في هذه الساحة. وهذه البناية نفسها تستخدم لمشاهدة سباق الخيل في الساحة الكبرى للسباق التي تبدأ من هذا المكان وتتجه نحو الشرق متخذة شكلاً بيضوياً محيطه أحد عشر كيلومتراً ونصف تقريباً. والبناية المذكورة تقع أيضاً على محور القصر الممتد من باب العامة، والذي يصل طوله إلى هذا المكان حوالي (1400) متر.
توزيع أقسام البناية:
إن إلقاء نظرة دقيقة على مخطط القصر، ومراجعة ما أوردته المصادر العربية من خلال الإشارات العابرة فيها، يمكننا توضيح بعض الأمور ذات العلاقة بطبيعة أقسام هذا القصر الكبير والخدمات التي تؤديها.
لقد كان مدخل القصر المعروف باسم باب العامة يطل على شارع الخليج الذي يعتبر من الشوارع المهمة في سامراء العباسية، وهو المدخل الرئيس للقصر لاعتبارات هندسية تتمثل في كونه يؤدي إلى الأقسام والأبنية المهمة بشكل متميز وواضح.
ويبدو أن إقامة ثكنات الجند في القسم الشمالي للقصر كان ضرورياً؛ لحماية وحراسة القصر وبيت المال الخزائن العامة والخزائن الخاصة الموجود في هذا القسم، إضافة إلى الاحتمال الكبير لاتخاذ هذا القسم موضعاً خاصاً بالخليفة وعائلته ومن هم من الأسرة العباسية المتصلة بالخليفة، حيث تتضح فيه الأسوار والمرافق
ص: 92
السكنية المتعددة، إلى جانب اتصال هذا القسم بمداخل متعددة مع الساحة الكبرى للقصر، وليس من المستبعد أن يكون القسم الجنوبي من القصر من مناطق إقامة الحاشية المكلفة بخدمة الخلافة العباسية، وتوفير الحاجات الضرورية لها، خاصة وإن هذا القسم قريب من أسواق المدينة نفسها، ويؤيد هذا الرأي تناثر الأبنية والوحدات السكنية فيه بشكل غير منتظم، ووجود مجموعات من الحجرات المصفوفة بأعداد كبيرة وبأحجام صغيرة نسبياً.
وبالنسبة إلى القسم الشرقي فالأبنية فيه غير كثيفة، ولا شك في أن بعده عن المنطقة المأهولة، ووجود مساحات كبيرة من الأراضي الخالية من البناء قد ساعد على إقامة ساحات ألعاب الفروسية وسباق الخيل في ذلك المكان إضافة إلى إقامة سرداب تحت سطح الأرض بعيداً عن الأنظار للراحة واللهو والتسلية.
الخصائص العامة لتخطيط القصر :
إن أبرز ما يتميز به مخطط هذا القصر هو ظاهرة وجود محور وسطي، تتوزع على طرفيه الكتل البنائية والوحدات السكنية، ويمكن ملاحظة بدايته من المدخل الرئيس للقصر (باب العامة)، الواقع في الجهة الغربية، حيث يمر وسط أروقة وفضاءات (ساحات)، ثم مجلس الخليفة، حتى يصل الساحة الكبرى للقصر فيجتازها بعد أن يقسمها إلى قسمين متناظرين، ويمر بهاوية السباع، ثم ساحة الفروسية، منتهياً بالبناية المخصصة لمشاهدة ألعاب الفروسية وسباق الخيل. وهذا التخطيط المحوري نلاحظه في معظم أجهزة القصر وأقسامه ووحداته السكنية.
وتميز هذا القصر بالامتدادات المستقيمة للأبنية والجدران على شكل خطوط تتقاطع مع بعضها في زوايا قائمة، وتتكون منها مساحات مستطيلة أو مربعة، ويغلب على الأروقة والحجرات الشكل المستطيل الذي يساعد على التسقيف بالأقبية، إضافة إلى سهولة تسقيفها بالسقوف الخشبية المسطحة وهي على العموم تحيط بالساحات
ص: 93
المكشوفة التي تعتبر بمثابة مصدر الضوء والهواء لها، والتي تتخذ شكلاً مربعاً في الغالب، كما تظهر بشكل مستطيل أحياناً. ويمكننا أن نلمس بوضوح مكانة الأروقة وتناسقها مع الساحات المكشوفة، مما يوفر استمرار الظل والتخلص من حرارة شمس الصيف وأمطار الشتاء والظروف المناخية القاسية الأخر.
أما بالنسبة إلى توزيع كثافة الأبنية فإن لها علاقة بطبيعة المنطقة نفسها، فالجناح الغربي للقصر الذي يوجد فيه المدخل الرئيس نلاحظ فيه كثافة في البناء، وضخامة في الجدران وتزيينها بالزخارف الجصية والرسوم الملونة، وزخارف المرمر والفسيفساء. وهذا بدون شك يدل على أهمية هذا القسم أكثر من سواه.
ويبدو لنا أن اتخاذ هذه المساحة الشاسعة للقصر إنما كان بقصد توفير وسائل الراحة والتسلية واللهو للخليفة وحاشيته والمتمثلة في الساحات المختلفة والبرك والنافورات وأحواض المياه والسراديب والأنفاق.
مواد البناء:
إن أبرز مواد البناء المستعملة في الجدران هو الآجر مع مادة الجص المستعملة للربط ، وقطع الآجر ذات شكل مربع قياسات القطعة الواحدة (28×28×8) سنتمتر. مع ملاحظة استعمال ذلك في الأقسام المركزية المهمة من القصر.
أما الأسوار وبعض الأقسام فقد استخدم في بنائها قطع مربعة من اللبن المصنوع من التربة المحلية وبقياس (28×28×6) سنتمتر، مع استعمال الجص كمادة للربط أيضاً. وتوجد بين أطلال القصر جدران مبنية بقطع كبيرة من الحصى، موضوعة بشكل صفوف متوازية مفصولة بعضها عن بعض بكمية كبيرة من مادة الجص. ويبدو أن هذه الطريقة في البناء استخدمت لتفادي الاعتماد الكبير على مادة الآجر الذي قد يصعب توفيره بكميات كبيرة وبالسرعة المطلوبة. ومن المحتمل أن يكون استعمال ذلك في مواضع قليلة من القصر إنما يرجع إلى طبيعة المكان.
ص: 94
أما بالنسبة إلى سطح الجدار فإنه في الغالب كان مغطى بطبقة من الجص، سواء كان مزخرفاً أم غير مزخرف، حيث استخدمت زخرفة جدارية محفورة تغطي القسم الأسفل من الجدار، إلى ارتفاع يتراوح بين (90-130) سنتمتراً، في حين استخدمت أشرطة وإطارات بسيطة على شكل عضادات تحيط بجانبي فتحات الأبواب. وفي بعض الأحيان استخدمت زخارف بالألوان على الجص أيضاً. وإلى جانب ذلك استخدمت ألواح من الرخام والمرمر في تغطية الأقسام السفلى من الجدران، وكانت أحياناً تحمل زخرفة بارزة متنوعة ربما استخدمت في تزيين الأقسام المهمة من القصر.
وتجدر الإشارة إلى استخدام الأعمدة الرخامية في البناء حيث عثر على بقايا منها، ولوحظ وجود ثقب يخترقها لتثبيت التاج أو القاعدة. كما أن للأخشاب دوراً كبيراً في التسقيف على العموم، بل وفي تثبيت وتقوية البناء نفسه من خلال استعمالها مع مواد البناء، إضافة إلى كونها من مواد الزخرفة المهمة.
هذا ولابد من الكلام عن الأرضيات التي كانت من الآجر في الغالب، حيث استخدم في تبليط الساحات المكشوفة بوجه خاص نوع كبير من الآجر قياسات القطعة الواحدة (45×45×5) سنتمتر، وأحياناً (36×36×8) سنتمتراً أو (30×30×4) سنتمتراً. واستخدمت مادة الجص في الأرضيات، حيث اكتشفت في بعض الحجرات والحمامات وكانت أحياناً ممزوجة مع قطع الحصى الصغيرة، وكانت مادة (القير) مفضلة في تبليط الحمامات والمرافق الصحية ؛ لكونها مانعة للرطوبة، حيث عثر على أمثلة منها. وفي بعض الوحدات السكنية استخدمت ألواح الرخام في التبليط أيضاً.
العمارة والعناصر العمارية :
كان لطبيعة الأرض واختلاف مستوياتها دور في استخدام الجدران الضخمة في معظم أقسام القصر، وفي بناء الأقبية تحت سطح الأرض في بعض أقسامه. وقد تمت معالجة احتمال الانكسار والتصدع نتيجة ضخامة الجدران وارتفاعها. واستعمال
ص: 95
طابقين من البناء في بعض الأقسام وبسبب السرعة في إنجاز البناء، حيث جرى استخدام قطع من الأخشاب القوية الجيدة بشكل داخل مع البناء ومترابط مع مواد البناء نفسها فكانت بمثابة روابط رباط) تزيد من قوته وتماسكه، وقد اتخذت أشكالاً مختلفة وأوضاعاً شتى، فنجدها ذات شكل عمودي قائم مع ارتفاع الجدار أو بشكل طولي أو أفقي متواز مع الصفوف الأفقية لقطع الآجر، أو بشكل مستعرض يدخل في عمق الجدار نفسه. وهناك أمثلة اجتمعت فيها الأشكال المذكورة. فعثر على قطع خشبية متباينة الطول والحجم، يتراوح معدل مقاسات المقطع للقطعة الواحدة بين (25× 20) سنتمتراً ، و ( 20 × 15) سنتمتراً.
إن بناء الأقبية تحت سطح الأرض كانت ذات فائدة كبيرة في استخدامها كمواضع ومخازن للمياه المستعملة أو ما يعرف بالبالوعات)، حيث تتسرب منها المياه تدريجياً نتيجة ارتفاع أرض القصر بالنسبة لمستوى مياه النهر والأرض المجاورة، وتمت عملية تصريف المياه أحياناً باستخدام مجارٍ فخارية لتسهيل انسيابها والتخلص منها. ويؤيد استعمال هذه الأقبية للغرض المذكور تلك التي ما تزال موجودة في منطقة باب العامة، حيث ظهرت فيها فتحات بنيت بعناية وتنحدر المياه إليها، في حين لم يعثر في تلك الأقبية على مداخل أو أية طريقة يمكن الدخول إليها بواسطتها.
العقود والأقبية:
كان الاعتماد كبيراً على استخدام الأخشاب في التسقيف وفي إقامة فتحات المداخل والنوافذ، وهذا ما تشير إليه المراجع العربية (1) ، وما تم العثور عليه خلال
ص: 96
أعمال التنقيب والصيانة التي أجريت في الموقع، فقد اكتشفت مواضع القطع الخشبية وبقاياها في بعض الجدران المتبقية، في حين عثر على قطع خشبية كاملة باقية في مواضعها الأصلية، وكان استعمال هذه القطع الخشبية في الأماكن المبنية بالآجر والمبنية باللبن على حد سواء. هذا بالإضافة إلى القطع والكسرات الخشبية الكثيرة التي وجدت بين أنقاض الأبنية خلال الأعمال الجارية في الموقع ، بينها ما هو كبير الحجم وما هو مزخرف بطريقة الحفر أو بالألوان، والجدير بالذكر أن استعمال الخشب ساعد على إقامة فتحات للمداخل والنوافذ ذات شكل مستطيل أو مربع دون اللجوء إلى بناء العقود في أعلاها، مما يوفر سرعة في إنجاز العمل واقتصاداً في النفقات.
إن استخدام الخشب في التسقيف لم يكن بديلاً عن إقامة العقود فوق الكثير من الواجهات والفتحات. وكانت النسبة المفضلة بين ارتفاع العقد وعرض فتحته هي (1:2) في الغالب. أما شكل العقد فكان مديباً على العموم ومن النوع المعروف بالعقد المدبب ذي المراكز الأربعة الذي ما زال يشاهد بوضوح في بناية باب العامة وهذا النوع سبق أن عرفت أمثلة عنه كما في باب بغداد بالرقة التي يعود تأريخها إلى سنة 155 هجرية (772 ميلادية)، وهو ما زال قائماً إلى اليوم (1) ومن الجدير بالذكر أن هذه العقود المدببة نجدها في الأبنية المبنية بالآجر أو اللبن أو المحفورة داخل الأرض.
وفي مجال التسقيف استخدمت نفس العقود المذكورة وامتداداتها التي تتكون منها الأقبية مما يوفر سهولة بمدها طولياً وتغطية المساحات المستطيلة مهما كانت طويلة. وهذا ما نلاحظه في الأبنية المتبقية عند باب العامة. أما طريقة بناء القبو فمن المرجح أنها كانت تتم باستخدام قالب في الواجهة المسطحة وقالب عند الجدار الخلفي. وهذا ينطبق على الأواوين. ويتخذ كل صف من صفوف الآجر مستقلا
ص: 97
في بنائه بالنسبة إلى الصنف الذي يتقدمه أو الذي يليه سوى استعمال مادة الجص للربط بين صفوف البناء، والتي تساعد على سرعة جفافها على التصاق قطع الآجر مع بعضها وترابط الصفوف والتحامها وتماسكها.
ويبدو أن هناك أكثر من أسلوب في بناء تلك الأقبية. ففي باب العامة نجد أن القبو يبدأ في الواجهة بعقد مزدوج فقد استعملت قطع الآجر المربعة الشكل بصورة أفقية بحيث يظهر شكلها المربع أمام الناظر ، هذا بالنسبة إلى العقد في الأسفل، أما في الأعلى فإن الطريقة اختلفت حيث استخدمت قطع الآجر المربعة بصورة رأسية يظهر منها جانبها فقط (ثخنها)، ويبدو أن هذا الأسلوب يكسب البناء قوة ومتانة أكثر.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك سبق أن استخدم في باب بغداد بالرقة قبل سامراء.
أما خلف ذلك العقد المزدوج فيوجد القبو، وقد جرى بناؤه من الأسفل بصفوف من قطع الآجر، موضوعة بشكل أفقي، حيث يظهر جانبها فقط كما هو الحال في الجدران الاعتيادية. وبعد إنجاز بناء (25) صفاً يتغير أسلوب البناء، فتصبح أوضاع الآجر بشكل رأسي وبصورة عمودية على الصفوف التي قبلها وإلى مسافة (17) صفاً في تلك القطع الآجرية، حيث تصل إلى النهاية العليا للقبو.
هذا وقد سبق لهذا الأسلوب أن استخدم في قصر الأخيضر المرجح تأريخه في أواسط القرن الثاني الهجري (القرن الثامن الميلادي).
القباب:
اقتضت الضرورة العمارية في بعض المناطق من القصر إقامة القباب فوقها أو أنصاف القباب، وبصورة خاصة تلك التي يكون موقعها بمثابة مركز لتقاطع الأروقة والممرات، أو الأماكن التي هي بحاجة ماسة إلى دخول كمية كافية من الضوء إليها لوجودها في عمق البناية، ووجود وحدات سكنية بحاجة إلى توفير التهوية الجيدة والضرورية، بالإضافة إلى استخدام أنصاف القباب في الواجهات، كما في باب العامة،
ص: 98
لوجود دخلات عميقة تتطلب التسقيف ، فأصبحت تكسب البناء قوة، وتضفي على الواجهة فخامة وبهاء.
رغم عدم وجود قبة كاملة باقية في هذا القصر، لكن الباحثين والعلماء يرجحون وجود ذلك في أكثر من موضع من البناية. وعلى وجه الخصوص في المنطقة الممتدة من المداخل المؤدية للساحة الكبرى باتجاه باب العامة حيث عثر على أسس جدران أروقة متقاطعة تؤلف مربعاً في الوسط، حيث الاحتمال الكبير لوجود قبة فوقه لاعتبارات عديدة، من أبرزها توفير القدر الكافي من الضوء والهواء إلى هذه المنطقة والقاعات المحيطة بها، وهو أمر لا يتحقق في غير ذلك كالأقبية المتقاطعة مثلاً. وهناك احتمال وجود مثال آخر على كل من المنطقة القريبة من الركنين الشمالي الغربي والجنوبي الغربي من ساحة القصر لوجود مساحة مربعة ووحدات سكنية بحاجة إلى ذلك. أما بالنسبة إلى أنصاف القباب فيوجد مثالان بحالة جيدة في بناية مدخل القصر المعروف بباب العامة على جانبي الواجهة الخارجية واتخذت شكلها من نفس شكل العقد المدبب الذي يتوج الواجهة.
وطريقة بناء القباب المذكورة يمكننا الاهتداء إليها من المعالم القليلة المتبقية وخاصة أنصاف القباب السالفة الذكر، وكذلك من بقايا قبة الصليبية الواقعة في الجهة الغربية المقابلة من النهر على مقربة من قصر المعشوق والمرجح تأريخها في أواسط القرن الثالث الهجري (القرن التاسع الميلادي). وتلك الطريقة قوامها حنايا معقودة في الأركان تؤدي إلى تحويل الشكل المربع أو المستطيل إلى شكل مضلع أو مثمن فيسهل بناء الجزء الأسطواني عليه ثم إقامة القبة فوقه. ويذكرنا ذلك بما هو موجود في قصر الأخيضر المرجح تاريخه في أواسط القرن الثاني الهجري (القرن الثامن الميلادي).
ومن المعروف أن بناء القبة قبل العصر الإسلامي كان يتم بطريقتين رئيستين هما:
ص: 99
الطريقة الأولى المستعملة من قبل الرومان والبيزنطيين من بعدهم، وقوامها استعمال كتل بنائية في الأركان تتخذ شكلاً مثلثاً قاعدته إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل، مع وجود قليل من الاستدارة أو الانحناء في هذه القاعدة، وهذا مما يساعد على بناء الجزء الأسطواني من أسفل القبة، ومن ثم سهولة بناء القبة فوق هذا الجزء الأسطواني.
وقد جرى تطوير هذه الطريقة بتقسيم الشكل المثلث إلى عدة مثلثات أصغر حجماً، وجعلها من طبقتين أو أكثر ، وهذا ما كان مستعملاً في العمارة الإسلامية وخصوصاً في بلاد الشام وآسيا الصغرى.
أما الطريقة الثانية، وهي التي شاع استخدامها في العراق وبلاد الشرق قبل الإسلام، وتقوم على استخدام حنايا نصف كروية أو أقواس في أركان البناء لتحويله إلى مضلع أو مثمن، مما يوفر سهولة في بناء الجزء الأسطواني للقبة عليه، ومن ثم إقامة القبة فوقه (1) ، ويبدو أن هذه الطريقة الأخيرة قد نالت اهتماماً في الحضارة العربية الإسلامية، وبذلت الجهود من أجل تطويرها والارتقاء بها والاستفادة من تلك الحنايا بإضافة الزخارف عليها أو تقسيمها إلى أقسام متعددة، كما هو الحال في قصر الأخيضر.
ص: 100
الزخارف:
مما لا شك فيه أن هذا القصر المهم كانت فيه من الزخارف الجدارية ما يناسب مكانته، حيث عثر على بقايا قليلة منها من قبل البعثة الألمانية التي عملت في الموقع وتم كشف أجزاء قليلة أخر خلال الأعمال التي أجريت مؤخراً من قبل المؤسسة العامة للآثار والتراث.
كانت الزخارف مصنوعة من عدة مواد كالجص، والرخام والمرمر، وألواح القاشاني والآجر المزجج والفسيفساء، وحتى الخشب المزخرف بطريقة الحفر والألوان.
أما أسلوب عمل تلك الزخارف فيتم بطريقة الحفر، الرسم بالأصباغ المتنوعة، الفسيفساء المختلفة الألوان التطعيم بالحجر والصدف.
كان الإيوان الكبير في باب العامة مزيناً من الداخل بزخارف جصية على شكل أشرطة تدور بداخلها أغصان العنب المورقة، في حين زينت الجدران بأوراق ثلاثية الفصوص تشبه (اللوتس) مكونة في شكلها العام ما يشبه زهرة الزنبق كما عثر في الموضع المسمى مجلس الخليفة على زخارف جصية ورخامية وأحياناً ألواح من الرخام والمرمر المعرق والملون، وفي قسم الحريم استخدمت رسوم ملونة ذات أشكال مختلفة، كما عثر في أحد مداخل هاوية السباع ما يدل على استخدام مثل هذه الزخارف الملونة ولكن بأشكال مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الحفريات كشفت عن كثير من كسرات الأخشاب المزخرفة والملونة.
وبالنسبة إلى الزخارف المحفورة على الجص نجد أن معظم الزخارف المكتشفة في هذا القصر هي من النوع الذي يطلق عليه الطراز الثالث بالنسبة إلى الطرز الزخرفية الثلاثة التي اشتهرت بها سامراء وذاعت شهرتها في العالم الإسلامي كله. حيث نجد الزخارف تكتسب رونقاً وبهاء من خلال تنوع الأشكال وتجسيم العناصر
ص: 101
والطابع الرمزي الذي يميزها رغم تكرار العناصر نفسها وتغطيتها مساحات واسعة من الجدران.
والجدير بالذكر أن الزخارف الجصية التي اشتهرت بها سامراء العباسية تم تصنيفها من قبل علماء الآثار إلى ثلاثة أساليب زخرفية استناداً إلى طريقة صنعها وحفرها ومقومات عناصرها وأشكالها وتسلسلها التاريخي (1). فكان أقدمها الأسلوب الأول وتميز بأسلوب الحفر العميق ووضوح الأرضيات والدقة في محاكاة العناصر النباتية بشكل يجعلها قريبة الشبه بما هو موجود في الطبيعة رغم وجود التنسيق والتهذيب فيها . وكان العنصر الزخرفي الرئيس في هذا الأسلوب هو العنب بأغصانه وأوراقه وعناقيده حيث استخدمت الأغصان المتموجة وورقة العنب بحافتها المفصصة والمسننة وبما في داخلها من عروق رئيسة وعروق فرعية، ومن خصائص هذا الأسلوب اتساع الأرضيات وتجسيم العناصر في تقعرها وتحدبها كما هو الحال بالنسبة لورقة العنب المقعرة الشكل وعناقيد العنب المحدبة الشكل.
وفي الأسلوب الثاني تطورت العناصر المذكورة تدريجياً وأخذت تبتعد عن الطبيعة شيئاً فشيئاً، حيث اضمحلت فصوص ورقة العنب، وتم الاستغناء عن
ص: 102
العروق الفرعية والاكتفاء بالعروق الرئيسة للورقة فقط، وهي الأخرى ما لبثت أن تركت واستبدلت بنقاط تملأ سطح الورقة. ويبدو أن الطلب الكثير على هذه الزخارف وتوفير الوقت اللازم لعملها هما من أهم الدوافع لذلك التطور الكبير الذي طرأ عليها والمتمثل في تضاؤل الأرضيات، فأصبحت بشكل قنوات ضيقة، وبساطة العناصر الزخرفية وكبرها.
أما الأسلوب الثالث فإنه يختلف عن الأول والثاني من حيث طريقة عمل الزخرفة حيث استخدم الحفر المائل (المشطوف)، مما لا يدع مجالاً لظهور الأرضيات (الخلفيات)، واستغني عن العناصر الزخرفية السابقة بعنصر جديد هو المروحة النخيلية (البالمت) الذي يبدو أنه يحقق ما يصبو إليه الفنان من السرعة والسهولة في عمله وبسط الزخرفة على مختلف أنواع المساحات المطلوبة، إضافة لما يوفره من تنوع أشكاله ورسم أشكال مركبة منه ومتطورة عنه، وهذا ما كان دافعاً مهماً لبداية ظهور الزخرفة العربية الإسلامية المسماة بالتوريق العربي ( أو الأرابسك) في الفترة اللاحقة لسامراء.
نظام الري وتوفير المياه للقصر
يقول اليعقوبي: (واتسع الناس في البناء بسر من رأى أكثر من اتساعهم ببغداد وبنوا المنازل الواسعة إلا أن شربهم جميعاً من دجلة مما يحمل في الروايا على البغال وعلى الإبل؛ لأن آبارهم بعيدة الرشاء، ثم هي مالحة غير سائغة، فليس لها اتساع في الماء ولكن دجلة قريبة والروايا كثيرة) (1).
إن ارتفاع مستوى الأرض في سامراء عموماً جعل الاهتمام يتجه إلى إيجاد الأسلوب الأفضل والأسهل في سبيل توفير المياه بدلاً من طريقة نقله من النهر لما في ذلك من الصعوبة وعدم توفر الكميات الكافية. ويبدو أن ذلك قد أخذ بنظر
ص: 103
الاعتبار عند تأسيس مدينة سامراء، حيث (أقدم المعتصم من كل بلد من يعمل عملاً من الأعمال أو يعالج مهنة من مهن العمارة والزرع والنخل والغرس وهندسة الماء ووزنه واستنباطه والعلم بمواضعه من الأرض). ويبدو أن جلب المياه إلى سامراء قد تم بحفر قنوات جوفية داخل الأرض تأخذ الماء من أعالي سامراء من نهر دجلة وهي ما تعرف بالكهاريز. وقد اقتضت الضرورة نتيجة لطول المسافة التي امتدت إلى عدة كيلومترات أن تحفر آبار مفتوحة على تلك القنوات الجوفية كانت في الأصل لرفع واستخراج الأتربة من القنوات الجوفية وتنظيفها عند الحاجة من الترسبات والعوائق التي تحول دون جريان الماء وانسيابها.
وهذه الفتحات كانت على مسافات متفاوتة حسب طبيعة الأرض ولكنها على العموم تسير في خط واحد وهناك من الدلائل ما يشير إلى وجود قناة جوفية ( کهریز) يزود قصر الخليفة بالماء حيث ما تزال آثار فتحاته موجودة، وبقايا النافورات (فوارات المياه العديدة في هذا القصر المهم ما تزال تشاهد معالمها إلى اليوم.
القسم الثاني:
أعمال التنقيب والصيانة في القصر الفترة من حزيران 1981 لغاية كانون الأول 1982.
شملت الأعمال ما يلي:
1 - السور المحيط بالساحة الكبرى للقصر.
2 - الكشف عن وحدات سكنية صغيرة بمحاذاة السور الشمالي للساحة الكبرى وأعمال الصيانة والحماية فيها.
3- المنخفض الكبير (النفق) الذي يخترق الساحة الكبرى، وصيانة المكتشفات فيه.
ص: 104
4 - الجناح الغربي للقصر والمكتشفات في المنطقة الممتدة بين باب العامة والساحة الكبرى.
5 - مدخل القصر (باب العامة).
6 - منطقة هاوية السباع .
كانت المباشرة بتلك الأعمال الواسعة في شهر حزيران سنة 1981، وبعد الزيارة الميدانية للموقع والاطلاع على حالته جرى تحديد العمل في المرحلة الأولى باستظهار بقايا السور الضخم المحيط بالساحة الكبرى للقصر وتوضيح حدود هذه الساحة التي تراكمت فيها تلول كثيرة من الأتربة والأنقاض. والجدير بالذكر أن هذه الساحة الكبيرة كانت مستطيلة الشكل طولها من الشرق إلى الغرب (345) متراً وعرضها من الشمال إلى الجنوب حوالي (192) متراً، ويحيط بها سور ضخم مبني باللبن والجص ومدعم بالأبراج من الخارج بينما يزين وجهه الداخلي دخلات غير عميقة على طرفي كل واحدة منها أعمدة جصية مندمجة أو ملتصقة بالجدار، ومتوجة في أعلاها بعقود مدببة، هذا وقد غطي وجه هذا السور بطبقة من الجص.
أولاً : السور المحيط بالساحة الكبرى للقصر
بدأ العمل عند الركن الشمالي الشرقي لساحة القصر حيث بقي في الجهة الشمالية جزء من جدار السور طوله (18) متراً، وارتفاعه زهاء ثمانية أمتار بالنسبة للأرض الحالية، وعرضه (1,60) متر، بني بقطع من اللبن قياس الواحدة منها (28×28×6) سنتمتر واستعمل الجص كمادة للربط بينها. كما استعمل الجص أيضاً في تغطية الوجه الخارجي للجدار وفي إضافة بعض الزخارف الجصية البسيطة المتمثلة في الأشرطة البارزة وأنصاف الأعمدة الجصية الملتصقة بالجدار. وفي هذا الجزء من السور توجد ثلاثة مداخل بقي اثنان منها بحالة جيدة تقريباً حيث كانت فتحة المدخل مستطيلة الشكل عرضها (1,60) متراً وارتفاعها عن مستوى الأرض
ص: 105
الحالية (1,25) متر ، وكان ارتفاعه أكثر من ذلك بسبب استمرار امتداد طلاء الجص تحت مستوى الأرض الحالية المغطاة بالأتربة والأنقاض حيث عثر على أرضية من الجص على عمق متر ونصف من ذلك كما سنرى فيما بعد. هذا وكان سقف المدخل مسطحاً ويستند على قطع خشبية ما تزال مواضعها ظاهرة بوضوح داخل الجدار وعلى جانبي كل فتحة.
وقد لوحظ في هذا الجزء من السور وجود حنايا أو دخلات غير عميقة لها عقود مدببة في أعلاها ظهرت اثنتان منها على الوجه الداخلي للسور. وقد تم استظهار ذلك ورفع وإزالة الأتربة والأنقاض المتراكمة على جدار السور وأمامه والتي يتراوح ارتفاعها بين (40 - 90) سنتمتراً حيث كشفت أرضية الساحة وكانت مبلطة بآجر جيد الصناعة قياس القطعة الواحدة (30×30×4) سنتمتراً. وقد كان التبليط المذكور يغطي أجزاءً متفرقة أمام المداخل الثلاثة السالفة الذكر.
وبعد اكتشاف بنايتين ملاصقتين للسور تمتدان بمقدار (18) متراً تقريباً، وسيأتي الكلام عنها، استمر العمل في تتبع السور باتجاه الغرب حيث كان مندثراً وزالت معالمه بسبب التخريب وأعمال البحث عن الآجر الموجود في الأساس الواقع على عمق متر ونصف تحت مستوى أرض الساحة الحالية، مما جعله يصبح بشكل خندق امتلأ بمرور الزمن بالأتربة والأنقاض التي تم استخراجها واستظهار المعالم المتبقية من جدار السور فكان ذلك بطول (33) متراً، ظهر خلاله مدخل بقي جانب واحد منه فقط، وهو يربط القسم الشمالي للقصر بالساحة الكبرى.
ثم وصل العمل إلى جزء من السور يرتفع بمقدار مترين عن تبليط الساحة وطوله (7,50) متراً. وهذا الجزء يتصل بجزء آخر من السور يرتفع إلى أكثر من سبعة أمتار، حيث تم استظهار الوجه الداخلي لجدار السور ورفع الأتربة والأنقاض المتراكمة عليه وفوق المساحة الواقعة أمامه، فظهرت أرضية مبلطة بآجر مربع الشكل قياس (30×730) سنتمتراً.
ص: 106
وكان جدار السور يحتوي على دخلات قليلة العمق على غرار ما شاهدناه عند الشمالي الشرقي للسور. كما لوحظ أيضاً وجود بعض الزخارف البسيطة المتكونة من أشرطة بارزة تؤلف مربعات ومستطيلات متداخلة ولكنها بحالة غير جيدة.
وفي هذا الجزء المرتفع من السور توجد فتحتان لمدخلين يربطان القسم الشمالي من القصر بالساحة الكبرى إحداهما متهدمة وعرضها ( 1,60 ) متر ، والثانية عرضها (1,70) متر ، لكنها أكثر ارتفاعاً وذات عقد مدبب في أعلاها.
وبعد ذلك وصل العمل إلى جزء آخر مفقود من جدار السور طوله / 5 20 متراً فجرى رفع الأتربة والأنقاض المتراكمة عليه وجعله بمستوى أرضية ساحة القصر ودون الحفر بصورة عميقة بحثاً عن الأجزاء المتبقية من السور، مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكانية استئناف العمل في المستقبل القريب خلف السور لرفع الأنقاض المتراكمة والكشف عن الأقسام الشمالية للقصر، واستخدام هذه الفتحة في السور كطريق مهم لتنفيذ تلك الأعمال، هذا من جهة.
ومن الجهة الأخرى، فإن تساقط الأمطار في موسم الشتاء هذا جعلنا نعيد النظر في إجراء الحفر بعمق للبحث عن بقايا السور ولو بصورة مؤقتة، والاكتفاء باستظهار موضع السور إلى حين حلول الوقت المناسب. يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن هذا الجزء من السور كان أمامه تل كبير (ربما مترب على الأغلب)، تتجمع فيه الأنقاض إلى ارتفاع يزيد عن ثلاثة أمتار، ويحتل مساحة تبلغ حوالي (400) متر مربع، حيث جرى رفعه واستظهار ما تحته من تبليط الآجر المربع الشكل، قياس القطعة الواحدة منه (35×35×7) سنتمتر.
ثم انتقل العمل إلى جزء متبق من جدار السور يصل ارتفاعه إلى مستوى ارتفاع الجزء الذي سبقت الإشارة إليه، وهو متشابه معه كذلك من حيث وجود المدخلين، كان الأول يشكل فتحة ذات عقد مدبب مرتفع كامل الشكل تقريباً، والثاني بشكل
ص: 107
فتحة واسعة متهدمة الجوانب غير معروفة القياسات الأصلية. وجرى استظهار أسفل الجدار والمساحة الموجودة أمامه، حيث ظهرت أجزاء من أرضية مبلطة من الآجر المربع الشكل. وهكذا استمرت الأعمال حتى تم الوصول إلى المنخفض الذي يقطع الساحة الكبرى من الشمال إلى الجنوب بما يشبه مجرى النهر، وبذلك أصبحت المساحة التي جرى فيها العمل تبلغ حوالي (220) متراً طولاً ، وأكثر من (15) متراً عرضاً.
وبعد المنخفض المذكور جرى تتبع السور الشمالي وكانت معالمه مندثرة فجرى رفع الأنقاض المتراكمة عليه وجعله بمساواة الساحة الكبرى، ولوحظ وجود أبنية من الآجر كانت ملاصقة لهذا الجزء كانت ملاصقة لهذا الجزء من السور من جهة الشمال.
وهكذا وصل العمل إلى الركن الشمالي الغربي، حيث ظهرت عدة بقايا زخرفة جصية جدارية بسيطة على شكل عضادات أو أشرطة بارزة قليلاً تؤلف مستطيلات متداخلة، وعند ذاك انتهى العمل في استظهار الوجه الداخلي لجدار السور الشمالي للساحة الكبرى والذي بلغ طوله (345) متراً.
أما في الجهة الشرقية من الساحة الكبرى فإن العمل ابتدأ من الركن الشمالي الشرقي كما سبقت الإشارة اليه، وتم استظهار أسس السور المبنية بالآجر، وعثر على معالمه المتبقية على عمق زاد عن مترين تقريباً، وكان بحالة غير جيدة، وتعرض إلى أعمال تخريب الباحثين عن قطع الآجر الموجود في الأسس. وقد تراكمت على موضعه الأتربة والأنقاض إلى ارتفاع أكثر من متر فوق مستوى الأرض المجاورة، وجرى رفع وإزالة ذلك حيث وصل العمل إلى مسافة (40) متراً تقريباً.
وفي أوائل سنة (1982) بدأ العمل في استظهار السور الغربي للساحة، حيث يوجد الجناح الغربي للقصر والمدخل المعروف بباب العامة، كان هذا القسم من السور مغطى بالأنقاض والأتربة التي أصبحت على شكل مرتفعات أو تلول وصل ارتفاعها
ص: 108
إلى أكثر من خمسة أمتار، وكانت تشغل مساحة يتراوح عرضها بين (20-60) متراً، حيث جرى رفعها وإزالتها ثم استظهار بقايا جدار السور الذي بني باللبن والجص وكان عرضه (1,60) متر . على أن الأجزاء المتبقية منه لا يزيد ارتفاعها عن مترين. والجدير بالذكر أن طول السور في هذا الجانب يبلغ حوالي (192) متراً، وأنه كانت تتوسطه أبنية أو جدران ضخمة بنيت بالآجر والجص بشكل بارز نحو الساحة.
وبعد ذلك جرى العمل في استظهار السور الجنوبي لساحة القصر حيث تراكمت عليه الأتربة والأنقاض أيضاً، حيث تم كشف جزء يقع في القسم الأوسط منه وإلى مسافة امتدت حوالي عشرين متراً طولاً، وكان عرضها حوالي عشرة أمتار، حيث كانت الأتربة فوقها ترتفع بين (0,50-2) متر ، فظهر قسم من السور مع الدخلات التي كانت تزينه، على أن ارتفاعه كان مترين تقريباً، ثم جرى العمل في حزيران من نفس السنة في القسم الممتد بين السور الغربي والمنخفض الكبير (أو النفق) الذي يقطع الساحة من الشمال إلى الجنوب، فتم رفع وإزالة الأتربة والأنقاض المتراكمة على مساحة وصل طولها مائة وعرضها أكثر من خمسة أمتار وإلى ارتفاع زهاء مترين تقريباً، ولكن جدار السور كان مندثراً تماماً، فآثرنا استظهار موضعه وتهيئته لأعمال الصيانة.
ثانياً: الأبنية المكتشفة بمحاذاة السور الشمالي
إن تتبع الأرضية المبلطة بالآجر ، والمكتشفة عند الركن الشمالي الشرقي لساحة القصر قد ساعدنا على الاهتداء إلى أبنية بدأت بالظهور تدريجياً بمحاذاة السور الشمالي وملاصقة له تماماً، حيث تم على بعد (18) متراً من الركن المذكور اكتشاف البناية الأولى، وكانت داراً صغيرة ذات جدران مبنية باللبن، قياس القطعة الواحدة منه (28×28×6) سنتمتراً، وعرض تلك الجدران يتراوح بين (55 - 60) سنتمتراً، أما ارتفاع الأجزاء المتبقية فيتراوح بين (10-60) سنتمتراً. وهذه البناية تحتل مساحة
ص: 109
مستطيلة الشكل طولها (16) متراً، وعرضها (9,60) متراً، ولها مدخل في الجانب الغربي عرضه (15 ,1) متراً، يؤدي إلى ممر صغير مساحته ( 2٫60×2٫20) مترمربع له فتحة تؤدي إلى ساحة الدار ، وهي واسعة نسبياً قياسها ( 7,90 ×5,40 ) متر مربع.
وعلى الجهة اليسرى للداخل توجد حجرة صغيرة مربعة الشكل، طول ضلعها (2,60 ) متر لها مدخل على ساحة الدار عرضه (1/15) متر، بينما توجد على طول الجهة الجنوبية للدار ثلاث حجرات متجاورة، مساحة الحجرة الأولى القريبة من مدخل الدار هي (4,90× 3,20 )متر مربع ، ولها مدخل عرضه (1٫10) متر يؤدي إلى الحجرة الوسطى ومساحتها (3,85 3,10) متر مربع، تطل على ساحة الدار بمدخل عرضه متران اثنان، كما لها مدخل آخر يتصل مع الحجرة الثالثة المجاورة والتي تبلغ مساحتها (5 × 10 ,3) متر مربع ، وهي واقعة في الجانب الشرقي للبناية حيث توجد بجوارها في نفس هذا الجانب أيضاً حجرتان أخريان صغيرتان إحداهما مساحتها ( 90 /2 × 45 / 2 ) متر مربع ، والثانية مساحتها ( 2٫90 × 2,35) متر مربع، وهي ملاصقة للسور الشمالي لساحة القصر تماماً، وذات أرضية وجدران مغطاة بطبقة من مادة (القير)، وفي جانب منها فتحة صغيرة تنفذ داخل الأرض، حيث يوجد مجرى لتصريف المياه المستعملة مبني بالآجر، ويلاحظ انحدار اتجاه الأرضية نحو الفتحة المذكورة، وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأن هذه الحجرة الصغيرة إنما كانت حماماً أو دورة مياه، حيث تعزز هذا الرأي بعد العثور على حجرة مماثلة لها في البناية الثانية المكتشفة بجوارها والمتناظرة معها تماماً، وكانت بحالة جيدة أكثر ومتكاملة التفاصيل وواضحة.
والجدير بالذكر أنه يوجد في هذه البناية الأولى جدار مبني بالآجر عرضه (1٫10) متر ، يقطع البناية ممتد من الشمال إلى الجنوب اعتباراً من جدار السور الشمالي وبمحاذاة ممر المدخل، وهو متأخر البناء كما هو واضح من وجوده بهذا الشكل ومن
ص: 110
بنائه الذي استخدم فيه آجر مختلف الأشكال، وأحياناً كثيرة تتخلله كسرات من قطع الآجر. هذا مع العلم أن جميع جدران البناية المذكورة مبنية بقطع من اللبن ومغطاة بطلاء من الجص ، ولوحظ وجود بقايا عضادات زخرفية جصية بسيطة على شكل شريط بارز على طرفي بعض فتحات المداخل.
أما أرضية البناية فكانت مبلطة بآجر مربع الشكل قياس الواحدة (30 ×30 × 4 ) سنتمتراً.
هذا وظهرت الجدران من الخارج ذات دعامات مستطيلة بارزة بمقدار (15 - 20) سنتمتراً، وعرضها يتراوح بين (60 - 65) سنتمتراً. وعثر على بقايا مجرى مفتوح داخل الجدار لتصريف مياه الأمطار المتساقطة على سطح البناية (مزريب) عمقه حوالي (20) سنتمتراً، ينحدر بشكل انسيابي نحو الخارج في أسفله.
إن مدخل هذه البناية الأولى الواقع في الجانب الغربي منها يؤدي إلى ممر خارجي عرضه (20 ,2) متر، يمتد أمام الجدار الغربي للبناية اعتباراً من السور الشمالي لساحة القصر حتى الساحة الكبرى، حيث يتصل معها بمدخل عرضه (1,55) متر. وقد اتضح لنا أن هذا الممر يفصل بين بنايتين متناظرتين تماماً، فقد اكتشفت بناية ثانية ملاصقة للسور الشمالي ومتقابلة مع البناية الأولى السالفة الذكر، وظهر لنا أنهما متناظرتان ومتشابهتان في المساحة والتخطيط والشكل العام والتفاصيل.
وفيما يلي أهم المميزات والمظاهر العمارية للبنايتين المذكورتين:
1 - أقيم البناء بصورة ملاصقة تماماً لجدار السور الشمالي من ساحة القصر، حيث استفاد المعمار من وجوده واستغنى عن بناء جدار في هذا الجانب من البنايتين.
2- بنيت الجدران فوق طبقة من الدفن بلغت حوالي متراً ونصف المتر بالنسبة لأرضية الساحة الكبرى للقصر، والتي تم العثور عليها، مما يجعل تاريخ البناء متأخراً عن تاريخ بناء القصر نسبياً.
ص: 111
3- أقيم البناء فوق سطح أرضية الساحة الكبرى للقصر مباشرة دون حفر أسس للجدران.
4 - بنيت الجدران باللبن وكانت مادة الربط هي الجص، وبلغ عرض تلك الجدران بين (50 - 60) سنتمتراً.
5 - نظراً لكون الجدران مبنية باللبن وغير واسعة، مما يعرضها لخطر التصدع والانهيار بسرعة فقد استخدمت دعامات لتقويتها، ظهرت بارزة من الخارج وفي المواضع التي يستوجب وجودها فيها.
6- عالج المعمار تصريف مياه الأمطار المتساقطة على سطح البناية بفتح مجرى داخل الجدار ، وفي منطقة لا يؤثر وجوده فيها على قوة البناء، وبشكل انسيابي ومنحدر لمنع حدوث تأثير على البناء.
7- البنايتان الأولى والثانية مشتركتان في ممر واحد كبير يفصل بينهما، ولكل منهما مدخل مفتوح على هذا الممر الذي بدوره يؤدي إلى الساحة الكبرى للقصر.
8- وجود تناظر وتشابه بين البنايتين من حيث المساحة والتخطيط والشكل العام وتوزيع المرافق السكنية وعددها وموقعها وكانت كل بناية منهما متكاملة من حيث وجود المدخل والساحة الوسطية وحجرات النوم والمخزن والمطبخ والحمام.
إن اكتشاف البنايتين المذكورتين ومعرفة مستوى تبليط أرضية الساحة قد ساعد على الاستمرار في تتبع التبليط الذي ظهر بحالة جيدة في الأقسام الغربية خارج البنايتين المذكورتين وبمحاذاة جدار السور.
وقد أدى استمرار العمل إلى اكتشاف بناية ثالثة تقع على بعد (7٫90) متر من البناية الثانية، وحوالي (9٫70) متر إلى الجنوب من السور الشمالي، ولكن معظم معالم هذه البناية قد اندثرت، وما بقي منها يتراوح ارتفاعه بين (5 - 25) سنتمتراً فقط، حيث عثر على جزء من جدارها الشمالي طوله (11) متراً مع الركن الشمالي الشرقي
ص: 112
المتصل معه، وفيه دعامة بارزة بمقدار (20) سنتمتراً، وتتصل به من جهة الجنوب حجرة بقي منها جزء من جدارها الشرقي مع جزء من جدارها الجنوبي الذي يرتبط مع جدارها الغربي، ومساحتها (5٫30 × 3٫80 متر مربع، والجدران فيها مبنية باللبن عرضها (60) سنتمتراً. وتوجد دكة غير مرتفعة عند الركن الشمالي الشرقي للحجرة من الداخل مساحتها ( 80 ×70) سنتمتراً مربعاً، كما هناك دكة أخرى شبيهة لها عند الركن الجنوبي الغربي مساحتها (90×90) سنتمتراً مربعاً، وكان تبليط الأرضية فيها بالآجر الذي أصابه التخريب والتلف، وهو مربع الشكل قياس القطعة الواحدة منه ( 30×30× 7 ) سنتمتراً.
وعلى مسافة (32,50) متراً إلى الغرب من البناية الثانية اكتشفت بقايا بناية رابعة بموازاة السور الشمالي وعلى امتداد البناية الثالثة السالفة الذكر، وهي مبنية باللبن وذات جدران يتراوح عرضها بين (60 - 65) سنتمتراً، بقي منها ما ارتفاعه بين (10 - 40 ) سنتمتراً. وأبرز ما بقي منها جدارها الشمالي وطوله ( 15,60) متراً، مع دعامتين بارزتين على كل من طرفيه ودعامة في وسطه تقريباً، كل منها تبرز بمقدار (15) سنتمتراً عن الجدار. وهناك بقايا ثلاث حجرات متصلة بهذا الجدار من جهة الجنوب على شكل صف واحد، تبدأ الأولى من جهة الشرق، وهي صغيرة، طول ضلعها المتبقي (3,50) متر ، وعرضها غير معروف بسبب اندثار الجدار الذي لم يبق منه سوى (20 ,2) متر فقط. وهي تتناظر مع حجرة أخرى تقع في جهة الغرب من حيث المساحة، لكن ما بقي من طول جدارها (1,60) متر ، ولكل منهما باب عرض فتحته (1,05) متر يؤدي الحجة الوسطى الكبيرة نسبياً، والتي يبلغ طولها (5,40) متر، وهي الأخرى غير كاملة الجدران.
ولدى استمرارنا في العمل إلى الغرب من البناية الرابعة، وعلى بعد (66) متراً، وجدت بقايا بناية خامسة تشبه نظيراتها السالفة الذكر من حيث الجدران المبنية باللبن والمغطاة بطلاء من الجص ، ومن حيث شكلها وتقسيماتها واندثار أقسامها الجنوبية
ص: 113
التي زالت بسبب وقوعها في اتجاه الساحة الكبرى، وليس بجوار السور الشمالي كما هو الحال بالنسبة للبنايتين الأولى والثانية وقوام ما بقي منها الجدار الشمالي الذي يبلغ طوله ( 15٫50) متراً، وارتفاعه عن سطح الأرض الحالية (40) سنتمتراً فقط، وفيه دعامتان في الركنين ودعامة في الوسط كل منها تبرز بمقدار (15) سنتمتراً عن الجدران.
وظهرت بقايا ثلاث حجرات متصلة بالجدار المذكور من جهته الجنوبية، اثنتان منها صغيرتان على الطرفين، طول الضلع الكامل المتبقي فيها (3,60) متر ، والعرض غير معروف ولهما بابان عرض فتحة الواحد (1,10) متر، يؤديان إلى الحجرة الوسطى التي كانت كبيرة نسبياً، وطول الضلع المتبقي فيها (5٫50) متر.
وعلى بعد (24,80) متراً من البناية الخامسة المذكورة اكتشفت البناية السادسة، وهي ملاصقة تماماً للسور الشمالي وذات معالم واضحة وشكل متكامل، وقد بنيت جدرانها باللبن وعليها طلاء من الجص، وعرضها يتراوح بين (55 - 65) سنتمتراً، وارتفاع الأجزاء المتبقية منها يتراوح بين (5 - 150) سنتمتراً، حيث كان جزء من الركن الجنوبي الغربي وجزء من الجدار الشرقي بحالة غير جيدة واندثر الكثير منها. وأرضية البناية مبلطة بآجر كبير الحجم جيد الصناعة مربع الشكل قياساته (45 × 45 × 4) سنتمتراً، واستعمل معه آجر من نوع آخر أصغر حجماً، قياس الواحدة (30× 30× 7) سنتمتراً.
أما مدخل هذه البناية فيقع في الضلع الجنوبي لها، وعرض فتحته (15ر1) متر، على جانبيه دعامتان بارزتان من الداخل والخارج. فقد ظهرت على طرفي الفتحة دعامتان بنفس عرض الجدران تبرزان بمقدار (30) سنتمتراً كانتا لتثبيت الباب على الأغلب من الخارج، تبرز دعامتان أخريان على الجانبين بمقدار (15) سنتمتراً وعرض كل منهما (50) سنتمتراً، بينما من الداخل تبرز دعامتان أكبر حجماً وبمقدار (60) سنتمتراً وعرض (50) سنتمتراً. وهذا المدخل يؤدي إلى ساحة
ص: 114
وسطية مساحتها ( 6,05 ×6,20) متراً مربعاً، وتوجد في الجهة الشرقية منها، وعلى يمين الداخل حجرتان لهما مدخلان على الساحة، إحداهما صغيرة، ربما كانت حماماً، حيث ظهرت مادة (القير ) على بقايا أرضيتها المندثرة، ومساحتها (4,15× 2,10) متراً مربعاً، وعرض فتحة مدخلها (1,05) متراً، وبجوارها حجرة ملاصقة للسور الشمالي مساحتها (15× 14×3,50) متراً مربعاً، وعرض فتحة مدخلها (1,05) متراً.
وتوجد في الجهة الغربية وعلى يسار الداخل حجرتان أخريان إحداهما مساحتها (2٫304,75 متراً مربعاً والثانية ملاصقة للسور الشمالي، ومساحتها أكبر من ،سابقتها، وتبلغ (4,75 3,15) متر مربع. هذا ولوحظ وجود الدعامة الركنية × عند الركن الجنوبي الشرقي للبناية على غرار ما هو موجود في الأبنية الأخر المكتشفة.
هذا وتميزت هذه والبناية السادسة بشكلها المتكامل المختلف قليلاً عن البنايتين الأولى والثانية كما اوضحت لنا بما لا يدع مجالا للشك في كونها والبنايات المكتشفة الأخر معها قد بنيت متأخرة عن بناء السور وفوق تبليط أرضية الساحة الكبرى مباشرة.
أعمال الصيانة والحماية
تم في سنة 1981 اكتشاف بنايات صغيرة، بعضها غير متكاملة بسبب تهدم واندثار أجزاء منها، حيث أقيمت بمحاذاة السور الشمالي، وبنيت باللبن والجص، ويبدو أن تاريخها متأخر بالنسبة إلى السور والساحة كما هو موضح من ملاصقتها للسور بشكل غير منتظم، ومن خلال إقامتها مباشرة على تبليط الساحة.
وفي أوائل سنة 1982 اتخذت بعض الإجراءات لحمايتها والمحافظة عليها، حيث تمت صيانتها بالجص وإلى ارتفاع لا يتجاوز نصف متر تقريباً، وهو أعلى ارتفاع للأجزاء المتبقية منها تقريباً، وفي نفس الوقت فإن ارتفاعها هذا لا يؤثر على ارتفاع
ص: 115
سور الساحة ومظهره العام.
وهكذا تمت صيانة البناية السادسة وهي متكاملة تقريباً، وتمثل داراً صغيرة لها مدخل بارز قليلاً يؤدي إلى ساحة وسطية تحيط بها حجرات صغيرة وحمام. وأنجز العمل في صيانة بقايا البنايتين الخامسة والرابعة وهما غير متكاملتين؛ لأن نصفاً من كل منهما مندثر تماماً بسبب امتداده نحو الساحة الكبرى للقصر، التي تعرضت لأعمال التخريب خلال العصور الماضية.
ثالثاً : المنخفض الكبير (النفق) في ساحة القصر
لدى وصول أعمال التنقيب إلى منطقة الالتقاء مع المنخفض، الذي يمتد قاطعاً الساحة من الشمال إلى الجنوب مما يشبه مجرى نهر مندرس حسب ما كان معتقداً به تم الحفر والتنقيب بعناية وتتبع طلاء طبقة الجص الذي يغطي الجدار لغرض الاهتداء إلى مستوى الأرضية، فعثر على أساس جدار السور وكان من آجر ومن عدة صفوف، ثم جرى الحفر بعمق أكثر قليلاً، فظهرت بقايا قبو بني بالآجر والجص مما استوجب تتبعه واستظهاره، حيث ظهر بأنه متهدم ومخرب وفقد معظم آجر البناء منه، وخاصة القسم العلوي الأوسط من القبو، وهذا بلا شك جعل شكل الموضع الذي كان فيه يشبه مجرى النهر ، وكان عرض القبو من الداخل (3,75) متر وارتفاعه من الداخل عن الأرضية الحالية له والمغطاة بطبقة من الجص كان (2,60) متر. ومما يوضح كونه حفر داخل الأرض الصلبة التي غطيت بطبقة من الجص قبل بناء القبو الذي بني بشكل عقد مدبب الشكل ؛ لكي يكسب مناعة وقوة مقاومة للضغط الحاصل عليه. وقد وصل طول القبو المبني بالآجر والجص حوالي (14) متراً، وأقيمت له فتحة كبيرة ودعامتان في مقدمتها زيادة في التقوية، لكن الخندق المحفور بعد ذلك، وطلاء الجص والأرضية الجصية استمرت بالظهور عند الاستمرار بأعمال الحفر والتنقيب باتجاه الجهة الجنوبية. كما لوحظ وجود فجوات صغيرة على الجانبين، وهي كذلك
ص: 116
محفورة داخل الأرض الصلبة.
هذا وقد اكتشفت أسفل جدار السور الشمالي فتحة تؤدي إلى قبو صغير بشكل نفق يخترق الأرض والسور باتجاه الشمال، عرضه متر ونصف المتر، وارتفاعه متران تقريباً، وكان على فتحته جدار بني لسدها، كما لوحظ أن جدار القبو الكبير المبني بالآجر يسد جزءاً قليلاً من فتحة النفق المذكور.
إن البحث والتنقيب داخل النفق الذي يخترق ساحة القصر قد كشف معالم جديدة، فتم استظهار معالم نفق آخر أصغر حجماً يتصل بالنفق الكبير المذكور عند وسطه تقريباً، ويتجه نحو السور الجنوبي للساحة وهو بشكل متعرج وله أرضية مبلطة بالآجر بحالة جيدة وجوانبه أيضاً بحالة لا بأس بها علماً أن عرضه (2٫10) متر، وإن العمل فيه وصل إلى طول (50) متراً.
ثم جرى العمل في الجهة المقابلة لفتحة النفق الفرعي المتصلة مع النفق الكبير حيث تم اكتشاف أرضية مبلطة بالآجر وبحالة جيدة، تنتهي بسلم صغير من خمس درجات يرتقي إلى ساحة القصر. وفي نهاية النفق الكبير عند منطقة التقائه السور الشمالي للساحة الكبرى للقصر تم استظهار سلم كبير يرتقي إلى الساحة من جهة الغرب يتكون من (14) أربع عشرة درجة طول الواحدة (1,60) متر، وعرضها (35) سنتمتراً، وارتفاعها (17) سنتمتراً تقريباً، وبأسفل السلم ممر طوله ثلاثة أمتار تقريباً، وعرضه وعرضه (1,60) متر ينتهي بالمدخل المؤدي إلى النفق الكبير ، وهو بعرض (95) سنتمتراً، وعلى فتحته تظهر فجوات داخله في الجدران تدل على منطقة تثبيت الباب.
هذا ، وكانت توجد فتحة عند نهاية النفق الكبير أي في نفس السور الشمالي لساحة القصر تم حفرها ورفع الأتربة منها، فظهرت بأنها نفق صغير يمر تحت السور وينتهي بسلم صغير ينحرف نحو الغرب، حيث كان طول هذا النفق (6,65) متر، وعرضه
ص: 117
(20 ,1) متر ، والسلم يبدأ بسبع درجات وهو بعرض (20 ,1) متر، وعرض الدرجة (27) سنتمتراً وارتفاعها (16) سنتمتراً، ثم ينحرف السلم إلى قسمه الآخر المتكون من اثنتي عشرة درجة تتشابه مع سابقتها، وهكذا ينتهي السلم في أعلاه بمساحة صغيرة يحدّها جدار ضخم من الآجر في جهة الغرب ربما فيه فتحة مدخل لم نتوصل إليه بسبب اندثار وتهدم الجدار.
وبالنسبة لأعمال الصيانة فقد تمت صيانة السلالم الثلاثة المكتشفة والمؤدية إلى النفق الكبير وتبليط المساحات المجاورة لها بالآجر . كما تمت المباشرة في صيانة وبناء قبو النفق الكبير في جهته الشمالية الملاصقة للسور الشمالي للساحة.
رابعاً: التنقيب والصيانة في الجناح الغربي للقصر :
جرى العمل في القسم الأوسط من الجناح الغربي في المنطقة المحاذية للساحة الكبرى. وقد استظهرت في بداية الأمر تلك الدعامة الكبيرة المتجهة نحو الساحة المذكورة والتي كان طولها حوالي (7) أمتار وعرضها (ثخنها حوالي (2,60) متر ، وهي مرتبطة مع جدار أقل منها في حجمه ولوحظ في بناء هذه الدعامة الضخمة وجود قطع منتظمة من الخشب موضوعة داخل البناء بشكل أفقي وعمودي ورأسي؛ لكي تترابط مع بعضها وتزيد من قوة البناء وتماسكه.
وتوضح المخططات الموضوعة عن القصر أنه كان في هذه المنطقة واجهة بارزة نحو الساحة ذات بناء ضخم فيها خمس فتحات للمداخل المؤدية من الجناح الغربي إلى الساحة الكبرى.
ورغم أن البناء المكتشف كان يصل في ارتفاعه إلى (2,30) متر تقريباً، إلا أن الأبنية والوحدات السكنية الواقعة خلفه لم تكن بحالة جيدة؛ لأن الجدران المتبقية فيها تنحدر حتى تصل تحت مستوى تبليط الأرضية بحوالي مترين، وذلك نتيجة
عبث وتخريب الباحثين عن الآجر للاستفادة منه.
ص: 118
هذا وقد تم كشف ما يلي:
1 - حجرة ملاصقة للسور الغربي والدعامة الكبيرة المذكورة سابقاً أي إنها بنيت في داخل ساحة القصر مساحتها (5×4) متر مربع ، ومدخلها عبارة عن فتحة كبيرة في جهتها الشمالية.
2- ممر صغير بين الحجرة المذكورة والدعامة الكبيرة مساحته (4×2) متر مربع ، يربط حجرة كبيرة خلف السور مع مساحة القصر .
3- حجرة كبيرة مزخرفة الجدران مساحتها (7,70× 4,40) متر مربع، لها مدخل يتصل بالممر المذكور سابقاً ومدخل آخر، يقع في الجانب الجنوبي، عرضه (55 ر1) متر .
4- حجرة أخرى مجاورة لسابقتها لها مدخل في الجانب الجنوبي عرضه (1,60 ) متر ومساحة الحجرة (6,70×40 ,4 ) متر مربع، وقد عثر قرب مدخلها على حنية أو دخلة مزخرفة على طرفيها أعمدة صغيرة بقيت منها قواعدها فقط، وهي بذلك تشبه المحراب يبلغ عمقها (55) سم، وعرضها من الخارج (120) سم.
5 - وفي الجهة الشمالية من الحجرة السابقة يوجد مدخل يؤدي إلى حجرة كبيرة لم ينته العمل فيها حيث تم كشف عرضها، وهو ( 20 ,5 ) متر ، بينما كشف من طولها مسافة ( 6,50) متر ، حيث لا تزال أجزاء منها مندثرة تحت الأنقاض المتراكمة، علماً أنه فيها ثلاثة مداخل في الشرق والغرب والجنوب.
6- حجرة أخرى مساحتها (20,5× 4,10 ) متر مربع مربع، تتصل مع سابقتها بمدخل، ولها مدخل اخر مقابل في جهتها الغربية.
7- حجرة أو حمام يتكون من قسمين، أحدهما صغير فيه آثار مواقد النار، والقسم الثاني كبير وفيه دكة مرتفعة للجلوس، والحمام يحتل مساحة عرضها أربعة أمتار وما كشف من طولها إلى الآن خمسة أمتار فقط.
ص: 119
8- حجرة كبيرة تتصل بالحجرة ذات المحراب المذكورة في رقم (4) من جهتها الغربية، طولها (8,30) متر وعرضها ( 40 /4 ) متر .
والجدير بالذكر أن جدران الحجرات المذكورة كان يتراوح بين (1-1,60) متر، باستثناء الحجرة رقم (1) والممر المجاور فإن الجدار فيهما عرضه (80) سنتمتراً. هذا وكانت معظم الجدران ذات زخارف جصية اندثر معظمها باستثناء الحجرة رقم (3) التي كانت زخارفها أحسن حالاً من غيرها. كما ان أرضيات الحجرات ذات تبليط من الآجر المربع الشكل ولكن بقياسات مختلفة نظراً لوجود إصلاحات فيه.
9 - ما يزال العمل مستمراً باتجاه (باب العامة) لاستظهار الأبنية المندثرة وفي هذا الجانب، حيث وصل طول المساحة التي يجري العمل فيها مئة متر تقريباً وعرضها عشرون متراً، وتتراكم كميات الأتربة والأنقاض عليها بمعدل مترين ونصف تقريباً.
أما بالنسبة لأعمال الصيانة في هذا الجانب، فقد جرى:
1 - صيانة الحجرة المرقمة (1) والارتفاع بجدرانها إلى حوالي (1,60) متر وبعرض (80) سنتمتراً، وأنجز البناء بالآجر المتيسر حالياً والاكتفاء بذلك إلى حين توفر الكميات الكافية من الآجر قياس (30×30 ×10) سنتمتر الذي يتناسب حجمه مع الآجر القديم.
2 - صيانة وترميم الحجرة المرقمة (3)، حيث تم بناء جدرانها إلى ارتفاع حوالي (2,30) متراً وبعرض وصل من جهتها الشرقية إلى حوالي (3٫20) متر، بينما كان في الجهات الأخر حوالي (1,60) متر . وهذه الحجرة ذات زخارف جصية تغطي القسم الأسفل من الجدران إلى ارتفاع (1,30) متر ويزداد ارتفاعها على طرفي المدخل الجنوبي لها، وقد أنجز العمل في صيانة وإكمال زخارفها المندثرة.
3- جرى العمل في بناء الجدران المندثرة للحجرة المرقمة (4)، وتم بناء حوالي متر ونصف تحت مستوى سطح الأرضية الحالية للحجرة، وحوالي متر فوق مستوى
ص: 120
الأرضية، وبعرض حوالي (1/60) متر.
4 - وبنفس الطريقة السالفة الذكر تمت صيانة جدران الحجرة المرقمة (5) وإلى نفس الارتفاع، وهو متران وكذلك الحال بالنسبة للحجرتين رقم (6) ورقم (7) مع ملاحظة زيادة عرض الجدران، إذ كانت في رقم (6) بعرض (1٫20) متر وفي رقم (7) حوالي (1٫30 ) متر .
هذا، وقد وصل العمل في هذا الجناح الغربي وعلى كل من طرفي الممر المؤدي إلى باب العامة إلى كشف مساحة طولها مائة متر وعرضها (20) متراً في كلا الجانبين، علماً أن الأتربة المتراكمة كانت بارتفاع يتراوح بين (2-5) متر.
ورغم أن أعمال التنقيب في الجانب الأيسر من الطريق الحالي المؤدي إلى باب العامة قد جرت في مساحة كبيرة، إلا أنه لم يعثر خلالها على أبنية أو جدران إلا بقايا قليلة غير متكاملة، يمكننا من خلال التدقيق فيها والاستنتاج بأنها كانت بقايا حمام؛ لوجود مواقد للنار تحت أرضيتها.
خامساً: مدخل القصر (باب العامة)
نظراً لوجود تصدع وتهدم في الجزء العلوي من فتحة المدخل في باب العامة، فقد بذلت الجهود من أجل نصب (صقالة) إلى الارتفاع المناسب، وتمت المباشرة بأعمال الصيانة وسد الفتحة المتهدمة فوق المدخل، واستعمل في ذلك الطابوق المقصوص بوجه جيد يتناسب مع بناء هذا المدخل وأهميته، حيث جرى العمل في مساحة يقدر طولها بحوالي (4) أمتار وبعرض حوالي مترين، وتم سد الثغرة التي كانت موجودة، وما زال العمل مستمراً لترميم الأجزاء المهدمة والمتساقطة في واجهة هذا المدخل المطلة على داخل القصر.
وقد بدا العمل مؤخراً في صيانة الجدران المتهدمة والمندثرة الموجودة على الجهة الشمالية من المدخل حيث موضع قبو كبير وحجرات أو قاعات كبيرة، وهذه الجدران
ص: 121
كبيرة وضخمة ومبنية بالآجر والجص ، حيث استعملت نفس المواد في أعمال الصيانة.
سادساً: منطقة هاوية السباع
كانت المباشرة بالعمل في هذه المنطقة خلال شهر آذار / 1982 ، وهي عبارة عن حفرة عميقة تحت سطح الأرض مساحتها مربعة الشكل، طول ضلعها (21) متراً، حفرت على جوانبها الأربعة حجرات في كل جانب ثلاث، وهذه الجوانب تتصل مع بعضها بممرات تؤدي إلى سلّمين يرتقيان إلى سطح الأرض، أحدهما في الجهة الشمالية والآخر في الجهة الغربية.
أما من الخارج فإن المنطقة كانت محاطة بصفوف من الحجرات والقاعات والممرات، وقد اندثرت معالمها الآن تحت التلول والأتربة المتراكمة، كما تعرضت مداخل السلّمين ودرجاتهما للتلف والاندثار، فأصبح أحدهما مغلقاً تماماً، وأصبح من الصعوبة اجتياز السلم الآخر بسبب تراكم الأنقاض.
إن أول الأعمال التي تم القيام بها هو فتح طريق للنزول إلى الداخل بواسطة أحد السلّمين وهو (الغربي)، فجرى تنظيفه وإزالة كتل الحجارة الكبيرة التي تعيق السير والحركة، فأصبح الطريق مفتوحاً للدخول إلى الممرات والحجرات التي تم رفع الأنقاض المتراكمة فيها، وكشف أرضية الممر المحاذي للسلّم، وكانت مبلطة بالآجر مربع الشكل قياس (30×30×7) سم، حيث ظهر بحالة جيدة من الحفظ.
والجدير بالملاحظة أن الممرات والحجرات رغم حفرها داخل الأرض وعلى عمق حوالي ثمانية أمتار عن مستوى سطح الأرض، فإنها حفرت في منطقة قوامها طبقة سميكة من الحصى الممزوج بالرمل والتراب مع تربة جصية وكلسية أحياناً، وهي بحالة غير شديدة التماسك مما يسهل الحفر فيها، ولكنه في نفس الوقت أصبح من الصعب المحافظة على مستوى مسطح منتظم للجوانب والسقوف، مما اقتضى تنظيمها بإضافة صف من الآجر بني بشكل وجه يغلف الجدران ويخفي عيوبها، بينما
ص: 122
غطي السقف بطبقة من الجص فقط.
هذا وكانت الجدران مغطاة بالجص ، وعثر على بعض منها مزدانة بزخارف جصية تزين القسم الأسفل منها، وهكذا أصبح العثور على الزخارف الجصية المحفورة وظهور بقايا أرضية مبلطة بآجر من نوع جيد، وبحالة جيدة واكتشاف بقايا ألواح من رخام مع الأنقاض، إضافة إلى المعلومات التي ذكرها العالم الألماني هرتسفلد، والتي تشير إلى وجود رسومات ملونة لبعض الحيوانات كانت تزين مدخل هذا الموضع ، كل ذلك يتناقض تماماً مع الفكرة السائدة من كون هذا الموضع (للسباع)، على أن اتخاذه سجناً لبعض الشخصيات المهمة هو الآخر أمر غير مقنع، وليست هناك نصوص تاريخية تؤيده ، ولهذا نرى اتخاذه سرداباً للراحة وربما للتسلية أقرب إلى الصواب.
وقد رافقت أعمال التنقيب ورفع الأتربة واستظهار الأرضيات والجدران أعمال صيانة وترميم بدأت في السلم الشمالي والمنطقة المؤدية إليه في الأعلى والممر المتصل معه في نهايته من الأسفل، حيث تم ترميم الدرجات وبناء المتهدم منها، وصيانة الجدران بالآجر، وتغطيتها بطلاء الجص، وبناء بعض الجدران الضخمة وتبليط أرضية المساحة الموجودة عند مدخل السلم من الخارج. أما السلم الغربي فقد كان بحالة سيئة جدا؛ لهذا تم بناؤه كله من جديد، حيث بلغت عدد درجاته (42) درجة بارتفاع (20) سنتمتراً للواحدة، وبعرض غير متساو وحسب ما كان عليه في الأصل، حيث يتراوح بين (1٫10 -1,25) متراً، ويجري العمل في صيانة وترميم الجدران والممر والحجرات في الجانبين الغربي والجنوبي.
هذا، وقد نقلت كميات كبيرة من الأتربة والأنقاض التي تراكمت داخل هذه المنطقة وذلك بواسطة الأحزمة الناقلة، كما ان التلول والأتربة المتراكمة في الخارج قد رفعت ونقلت لتسهيل حركة العمل وتوضيح المنطقة أمام الزوار.
ص: 123
اللقى الأثرية المكتشفة:
إن علم الآثار لا يهتم فقط بالكشف عن الأبنية المندثرة وصيانتها ودراستها، وإنما يعنى بالبحث عن اللقى الأثرية الصغيرة، والتي توضح لنا الجوانب الحضارية ونشاط الإنسان في مختلف المجالات.
وفي مدينة سامراء اكتشف الكثير من اللقى الأثرية من قبل بعثات التنقيب لأجنبية والعراقية والتي عملت فيها في السنوات الماضية، حيث أوضحت لنا جوانب مهمة من الحضارة العربية الإسلامية خلال الفترة الزمنية القصيرة التي عاشت فيها مدينة سامراء، والتي كان لها شأن كبير في تطور العديد من الفنون والصناعات والطرز العمارية والزخرفية وانتشارها في العالم الإسلامي.
سبق لنا في بداية البحث الكلام باختصار عن الزخرفة في سامراء، والتي نجدها مصنوعة من الجص والرخام وتزين جدران الأبنية، أو مصنوعة من الخشب الذي صنعت منه الأبواب والأثاث المنزلية الأخر، حيث كان لتلك الزخارف من الشهرة ما جعلها تنتشر في شرق العالم الإسلامي وغربه ، بل واستخدامها ليس فقط في العمارة، وإنما على التحف والمصنوعات الصغيرة بشتى أنواعها.
شاهد العالمان (فيوله) و (هرتسفلد) الزخارف الجدارية المتبقية في هذا القصر قبل الحرب العالمية الأولى (1)، فقد كان عقد الإيوان الكبير في مدخل القصر (باب العامة) مزداناً بزخارف جصية على شكل أشرطة، بداخلها أغصان العنب المتموجة على شكل دوائر تحصر بداخلها أوراق العنب، والتي روعي فيها محاكاة العناصر الطبيعية على نحو ما هو معروف في الأسلوب الأول من الأساليب الزخرفية التي اشتهرت بها سامراء، أما داخل الإيوان الكبير فكان مزيناً بزخارف جصية أيضاً لكن عناصرها تعتمد على الزهرة الثلاثية الفصوص، أو الزهرة التي تشبه زهرة الزنبق،
ص: 124
وهذا يجعلنا نعتقد أن هذا النوع من الزخرفة يمثل الأسلوب الأول من الأساليب الزخرفية التي اشتهرت بها سامراء.
وفي مجلس الخليفة والحجرات والقاعات المتصلة معه كانت الزخارف الجدارية مصنوعة من الرخام المحفور والمنحوت على غرار الزخارف الجصية، والتي كانت تزين القسم الأسفل من الجدران، وعثر خلال التنقيبات الماضية على زخارف ملونة على الجص، بعضها ذات أشكال آدمية وحيوانات، وذلك في القسم الجنوبي من الجناح الغربي للقصر، هذا بالإضافة إلى العديد من القطع الخشبية التي تحمل زخارف محفورة أو زخارف مرسومة بالألوان المختلفة، كما عثر على زخارف جصية تمثل الأسلوب الثاني من زخارف سامراء على شكل أوراد كبيرة ودوائر ومناطق زخرفية مختلفة الأشكال، لكنها جميعها مملوءة بعناصر محورة.
أما التنقيبات الحالية، فقد كشفت بقايا الزخارف الجصية في أطلال الجناح الغربي للقصر، إضافة إلى العديد من الأشرطة الزخرفية والكسرات الزخرفية المصنوعة من الرخام. كما تم الكشف عن زخارف جصية جدارية في بعض أجزاء منطقة هاوية السباع والجدير بالذكر أن هذه الزخارف المكتشفة جميعها من النوع المعروف بأسلوب سامراء الثالث. أما بالنسبة إلى الأخشاب المزخرفة فإن بعضها كانت عليه زخارف محفورة، والبعض الآخر عليه زخارف مرسومة بالألوان الزاهية، وتجدر الإشارة إلى أنه عثر أيضاً على أجزاء من أعمدة جصية صغيرة عليها زخرفة هندسية بارزة.
الفخار:
ويقصد به كل ما عمل من الطين وشوي بالنار، وتعتبر اللقى الفخارية من المواد الأثرية المهمة التي غالباً ما يعثر عليها المنقبون في المواقع والأبنية المندرسة، وهو خير دليل على قياس درجة المدنية ونوع الحضارة في شتى العصور.
ص: 125
إن المواقع الأثرية في العراق قد عثر فيها على الكثير من اللقى الفخارية، ونذكر منها المدن الإسلامية المشهورة كالبصرة والكوفة وواسط، إضافة إلى العديد من التلول الأثرية المنتشرة في أنحاء القطر، ولكن أهمية ما اكتشف في سامراء في كونه محدداً في تاريخه خلال الفترة الزمنية التي عاشت فيها هذه المدينة، والواقعة بين سنة 221 - 279 هجرية (836) - 889 ميلادية. ويبدو أن مدينتي البصرة والكوفة كانت صناعة الفخار فيهما مشهورة، حتى إن المعتصم عندما أقدم من كل بلد من يعمل عملاً من الأعمال أرسل إليه من البصرة من يعمل الزجاج والخزف والحصر، ومن الكوفة من يعمل الأدهان (1).
لقد تم اكتشاف مجموعة كبيرة من الكسرات الفخارية في قصر الخليفة مع ملاحظة وجود عدد قليل جداً من التحف الكاملة. ويمكننا تصنيف اللقى الفخارية إلى عدة أنواع بالنسبة إلى مادتها وطريقة صنعها منها ما هو مصنوع من:
1 - فخار أحمر اللون قليل الجودة؛ بسبب تعرضه إلى درجة حرارة منخفضة داخل الفرن.
2- فخار أصفر اللون قليل الجودة، بسبب خشونته وعدم جودة الطينة المصنوع منها.
3- فخار أحمر أو أصفر، لكنه جيد الصناعة و جید الطينة، ويمتاز بصلابته لعدم وجود المسامات فيه.
4- فخار أصفر، وقد يكون لونه مائلاً للأبيض، وهو جيد الصناعة ورقيق جداً ويمتاز بطيئته المتماسكة الجيدة الناعمة والعناية بالحرق داخل الفرن.
أما بالنسبة إلى الزخارف والنقوش التي تزين المكتشفات الفخارية في قصر الخليفة فكانت تنجز بالطرق التالية:
ص: 126
1 - طريقة الحز على سطح الفخار بواسطة أداة مدببة قبل عملية الحرق داخل الفرن، وقد استخدمت هذه الطريقة في صنع زخارف قوامها خطوط مستقيمة ومتموجة ودوائر وأشكال متنوعة أخر.
2- طريقة الختم على الفخار وتقوم في أساسها على استعمال ختم عليه نقوش غائرة أو بارزة يضغط على سطح القطعة الفخارية قبل دخولها إلى الفرن، وكان قوام الأشكال في الغالب أشرطة صغيرة وحبيبات بارزة صغيرة.
3- طريقة الإضافة نقصد بها تهيئة عناصر أو أشكال زخرفية تلصق مع القطعة الفخارية كما هو الحال بالنسبة إلى المقابض ذات الرأس المنتهي بشكل زهرة أو وردة أو أقراص ودوائر.
وأهم المكتشفات الفخارية في قصر الخليفة خلال هذه التنقيبات الأخيرة هي:
1 - أوانٍ عميقة نصف كروية الشكل تقريباً، أو نصف أسطوانية الشكل تقريباً، واحد منها مصنوع من فخار جيد أحمر اللون.
2 - أوانٍ تشبه الكأس الكبير بداخلها بقايا أصباغ، مصنوعة من فخار أصفر أو أحمر غير جيد الصناعة.
3-قارورة بيضوية الشكل من فخار صلب لونه مائل للأخضرار بداخلها فتيل للاشتعال .
4 - قارورة غير متكاملة من فخار صلب لونه أحمر.
5 - جرة مهشمة إلى كسرات عديدة وغير كاملة الشكل من فخار رقيق أصفر جيد الصناعة.
6- مجموعة من مقابض الجرار فخارية عليها نقوش زهرة أو وردة أو أقراص و دوائر.
ص: 127
7- كسرات قليلة عليها طبعات ختم زخرفي.
8- مجموعة من الكسرات الفخارية المختلفة الأنواع والأشكال والجودة في الصناعة والطينة المتنوعة بعض منها عليه نقوش محززة مختلفة، وهي تعود إلى جرار وأوانٍ صغيرة أو متوسطة الحجم أو كبيرة الحجم. إضافة إلى كسرات من فخار أحمر اللون مطلية بمادة سوداء (القير ) من الداخل.
الخزف:
آثرنا هنا استعمال كلمة الخزف على الفخار المزجج Glazed Pottery وقد سارت صناعة هذه المادة في العصر العباسي الأول على النهج المتبع في العصر الأموي، ويبدو أنها لاقت تشجيعاً لكثرة إقبال الناس عليها فظهرت مراكز فنية عديدة لها، ويشير اليعقوبي إلى استقدام الخليفة المعتصم للخزافين من مدينتي البصرة والكوفة مما يدل دلالة واضحة على ازدهار صناعة الخزف في هاتين المدينتين ثم انتقالها إلى سامراء وتطورها فكانت لها شهرة في العالم الإسلامي، حيث ظهرت منها أنواع عديدة أوضحتها نتائج التنقيبات في سامراء (1)، والتي كشفت عن مصنوعات خزفية متميزة بطينة ناعمة برتقالية اللون متماسكة الأجزاء، ذات ألوان متعددة كالأزرق أو الأخضر أو الأزرق المائل إلى الخضرة أو البني أو اللازوردي violet، أو الأبيض الحليبي Cream ، وهي على العموم تمتاز بنقوش أو زخارف قوامها نقاط أو بقع متناثرة Splached أو خطوط أو أشرطة Mottled ، وظهرت بينها كذلك رسوم أشكال الطيور والحيوانات، إضافة إلى الكتابات العربية.
ويمكننا تمييز عدة أنواع منها : نوع أول مزجج بلون واحد هو الأزرق أو الأخضر ومزين بزخارف بارزة أو محززة على نحو ما كان مألوفاً قبل العصر الإسلامي. ونوع ثانٍ عليه حزوز أو خدوش Graffito تؤلف أحياناً أشكالاً
ص: 128
هندسية وعناصر نباتية واستعملت معها الألوان المختلفة. ونوع ثالث فيه الزخارف مرسومة فوق طبقة التزجيج وهي ذات أشكال هندسية ونباتية وكتابات عربية. ونوع رابع كانت الزخارف فيه مرسومة تحت طبقة الطلاء الزجاجي الشفاف حيث لعبت الأكاسيد المعدنية دوراً كبيراً في الألوان المستعملة. وهناك نوع خامس مهم ابتكر في عصر سامراء وهو يسمى بالخزف ذي البريق المعدني Lustre pottery ظهر فيه اللون الذهبي والفضي والنحاسي أحياناً حيث وصلت المصنوعات من هذا النوع أرقى درجات الإتقان والجودة والمهارة في الصناعة وتناولت الزخارف فيه الأشكال الهندسية والنباتية والحيوانية.
هذا وتجدر الإشارة إلى نوع آخر عثر عليه في أطلال سامراء ويرجع في أصله إلى بلاد الصين كان قسم منه مزين بأشرطة زخرفية بشكل شعاع ينبعث من وسط الآنية، والقسم الآخر يمتاز بطينة جيدة وتزجيج أبيض غير شفاف عليه زخارف متنوعة ونظراً لما تتمتع به بلاد الصين من شهرة وتفوق في هذه الصناعة ومكانة مصنوعاتها لدى الناس عموماً فقد قام الصناع المسلمون بتقليدها وتطويرها وطبعها بطابع إسلامي مما جعلها تضاهي وتنافس الصناعة الصينية.
عثر في قصر الخليفة خلال التنقيبات الحالية على مجموعة كبيرة من القطع الخزفية المهشمة تدل على أنها أجزاء من جرار وأوانٍ كبيرة أو كؤوس وصحون مختلفة الأحجام، منها ما هو مزين بأشرطة أو بقع منثورة أو زخارف ذات ألوان براقة زاهية نلاحظ بينها عدداً قليلاً من كسرات مزخرفة ذات بريق معدني ذهبي اللون. وتجدر الإشارة إلى اكتشاف العديد من ألواح القراميد والآجر المزجج والمزين بفروع نباتية ذات لون بني على أرضية بيضاء ، أو بنقاط منثورة ذات ألوان عديدة يظهر بينها أحياناً اللون الذهبي أيضاً.
ص: 129
الزجاج:
إن مادة الزجاج كانت معروفة في العراق منذ العصور القديمة، ويبدو أن صناعة الزجاج كانت مزدهرة في البصرة مما جعل الخليفة المعتصم يأمر بإحضار أهل هذه الصناعة إلى مدينته سامراء (1)، حيث أقيمت معامل لهذا الغرض وكشفت التنقيبات قطعاً بديعة بأشكال مختلفة وأنواع شتى تدل على ما وصلت إليه صناعة الزجاج في سامراء من تطور ونضوج.
رغم تعرض قصر الخليفة إلى التخريب والعبث فإن التنقيبات الحالية فيه قد كشفت عن مجموعة من الكسرات الزجاجية المختلفة في ثخنها (سمكها) وفي ألوانها وتعود إلى أوانٍ كبيرة وقنانٍ صغيرة، على أنه تم العثور أيضاً على قنان كاملة الشكل وهي على العموم تتكون من بدن نصف كروي أو أسطواني مع عمق نحيف أنبوبي الشكل كما تم العثور أيضاً على قنينة صغيرة جداً ذات شكل مخروطي أو بالأحرى مغزلي لها فوهة واسعة نسبياً. وإلى جانب ذلك وجدت بقايا التحف الزجاجية كالمقابض الكبيرة وأعناق الدوارق الكبيرة الحجم والأواني العميقة التي تشبه (الطاسة). كما اكتشفت كذلك قطع زجاجية على شكل إناء معيني مقعر صغير الحجم ربما كانت تستعمل في تزيين الزخارف إضافة إلى قطع زجاجية ملونة معينية الشكل من المحتمل أنها كانت تستعمل في الزخرفة كذلك قد عثر على إناء صغير جداً نصف كروي الشكل أيضاً لكنه غير كامل.
الخشب:
من المعلوم أن الخشب مادة سريعة التلف وتشارك عوامل عديدة في اندثاره. وأغلب التحف الخشبية التي وصلت إلينا من سامراء لها علاقة وثيقة بالأبنية نفسها، كالسقوف والأبواب والشبابيك، أما الأثاث فإن ما وصلنا منه قليل جداً.
ص: 130
كان للخشب دور مهم في الزخرفة الإسلامية وتطورها وابتكار الأساليب المتنوعة. ويبدو أن الأساليب الزخرفية التي اشتهرت بها مدينة سامراء العباسية قد انتقلت من الجص إلى الخشب لسهولة تنفيذها عليه وخاصة العناصر والأشكال المعروفة في أسلوب سامراء الثالث. إن طرق الزخرفة على الخشب لم تقتصر فقط على حفر العناصر الزخرفية أو جعلها بارزة عن سطح الخشب، وإنما استخدمت الأصباغ في رسمها وظهورها بألوان زاهية.
خلال التنقيبات في قصر الخليفة تم العثور على مجموعات من بقايا الأخشاب المزخرفة بطريقة الحفر أو الرسم بالألوان المختلفة، وهي بأحجام وقياسات متنوعة. ومن المرجح أن الأخشاب الملونة كانت مستخدمة في سقوف البناية أو أجزاء الجدران القريبة من السقف وليس من المستبعد أن يكون استعمالها بصورة أشرطة تدور حول الجدران. ورغم أن العناصر الزخرفية غير متكاملة الشكل في بقايا الأخشاب المكتشفة فإننا نستطيع أن نميز الأوراد والأغصان والاوراق إضافة إلى الأشرطة والإطارات المتكونة من المثلثات ومن الدوائر المتداخلة.
هذا واكتشفت أثناء التنقيبات الأخيرة أيضاً بعض القطع الزخرفية المنحوتة بشكل دقيق وتعود إلى أثاث بيتية في الغالب، في حين وجدت قطع نصف كروية الشكل لا تزال مسامير الحديد الكبيرة باقية فيها مما يحتمل استخدامها في تثبيت الألواح الخشبية الكبيرة وتزيينها، أو في تثبيتها على الأبواب الخشبية كنوع من الزخرفة والزينة حيث كانت بعضها مصبوغة بألوان مختلفة.
مواد متنوعة:
إلى جانب المواد المذكورة سابقاً تم العثور على قطع فنية مصنوعة من الصدف ذات شكل دائري أو مربع أو معين أو بهيئة أوراق نباتية من المحتمل جداً أنها كانت ذات علاقة بالزخارف، وتستخدم في تزيين الزخارف الجصية وتطعيم الأخشاب.
ص: 131
وكذلك وجدت بقايا قطع نحاسية تمثل أدوات ومسامير للأبواب، إضافة إلى مسامير الحديد التي بشكل كبير ومثبتة في بقايا الأخشاب المكتشفة.
هذا، وتم العثور خلال الأعمال الحالية أيضاً على مجموعة من قطع الفسيفساء الصغيرة الحجم (نصف سنتمتر مكعب وأحياناً سنتمتر مكعب واحد)، وهي مصنوعة من الزجاج وبألوان عديدة أو من أحجار ذات ألوان مختلفة، ولاشك في كونها تمثل بقايا زخارف جدارية كانت في هذا القصر.
خلاصة بالأعمال والكمية المنجزة خلال الفترة 1891 / 2891
1 - توضيح معالم الساحة الكبرى للقصر واستظهار بقايا السور المحيط بها من الجهتين الشمالية والغربية وأجزاء من الجهة الجنوبية والشرقية. مع إجراء تنقيبات بمحاذاة السور من جميع الجهات.
2 - اكتشاف وحدات سكنية بشكل دور صغيرة بجوار السور الشمالي والسور الجنوبي للساحة.
3- استظهار معالم المنخفض الكبير الذي يخترق الساحة وكشف القبو الموجود فيه والمبني بالآجر مع السلالم المؤدية إليه من الساحة. كما تم الكشف عن النفق الفرعى المتصل معه والذي كان له قبو من الآجر مع تبليط جيد من الآجر .
4 - التنقيب عن جانبي الطريق الحالي المؤدي إلى (باب العامة) بطول مائة متر لكل جانب وبعرض زهاء عشرين متراً، واكتشاف بقايا وأسس حجرات متعددة.
5 - أعمال صيانة وحماية للمكتشفات الأثرية في ساحة القصر والنفق الكبير والحجرات في مدخل الطريق من الساحة إلى باب العامة وفي مدخل القصر (باب العامة) نفسه والجدران المتصلة معه.
6 - أعمال تنقيب وصيانة في المنطقة المسماة (هاوية السباع) واكتشاف زخارف
ص: 132
جصية في بعض الجدران فيها، وفتح السلمين التابعين لها وصيانتهما وإجراء صيانة للجدران الجانبية إلى ارتفاع حوالي مترين وفي الأقسام الغربية والجنوبية والشرقية.
7- جرت الأعمال المذكورة في مساحة تقدر بحوالي عشرين ألف متر مربع.
8- نتيجة للأعمال المذكورة، فقد تم رفع وإزالة كمية من الأنقاض والأتربة تقدر بحوالي خمسين ألف متر مكعب.
9 - اكتشفت خلال العمل بعض القطع الأثرية من الفخار والخزف والجص والزجاج والخشب والرخام والمرمر.
ص: 133
التحليل لنماذج الأصباغ داخل أوانٍ فخارية من سامراء (قصر الخليفة) (1)
اجرى التحليل لهذه النماذج مجهرياً وكانت النتائج كما يلي :
النموذج الأول : الوردي المحمر :
اعطى كشف موجب خاصة للحديد والرصاص
والصبغة من احمر الرصاص Red Lead pb3 O4 Minium of Lead
وأيضا من اوكسيد الحديد Fe2 O2 haematite
النموذج الثاني الاخضر :
كان من الاصباغ الطبيعية من الجبال وهو المالاكابت
Malachite Cu Co3. Cu (OH)2
وکذلك من اوكسيد الكروم omium oxide Cr2 O3 H2O
النموذج الثالث الازرق : Azurite2 cuco3. Cu(OH)2
من الاصباغ الطبيعية من الجبال وهي ارورايت
وكذلك من السيليكات وهي طبيعية لكل من الحديد
Fe والمغنيسيوم Mg والكالسيوم Ca والالمنيوم AL وبعض الشوائب من الكالسيت
النموذج الرابع أ ) اللون الاسود
وتحت المجهر بين غامق وهو من القير واعطى كشف موجب للحديد وكذلك بعض المواد العضوية المحروقة (Bitumen ) dark brown
ب) اللون الابيض : Calcium Sulphate anhydrite
وهو متكون بنسبة كبيرة من الحس
كبريتات الكالسيوم CaSo4 وقليل من المادة التباشيرية Ca Co3 كاربونات الكالسيوم النموذج الخامس أ) اللون المسود على زرقة :
عبارة عن الازورايت Azurite 2 Cu Co3 Cu(OH)2
وكذ لك قليل من اللون الازرق المسمى ربما يكون Egyptian blue Cao
Cuo2 4 Sio وشوائب من التربة اعطت كشف موجب للحديد بشكل اوكسيد الحديدوز والحديديك.
ص: 134
ب) اللون الاصفر : من الصبغة الطبيعية الاوكر الاصفرOcre Jaun
Fe2 O3 H2 O وكذلك من الطين والسيليكا . أما التحليل بواسطة اشعة ليزر ( تحليل نوعي بواسطة السيدتين بثينة مسلم ولمى عبد السلام ) فكانت النتائج كالاتي :
النموذج الأول : احمر Mg, Si, Ca,Fe, Cu, K, Pb
النموذج الثاني : الاخضر Mg, Si, Ca, Fe, Cu, Cr
النموذج الثالث : الازرق Mg, Si, Ca, Fe, Cu
النموذج الرابع : أ ) اللون الاسود Mg, Si, Ca, Fe, Cu
ب اللون الابيض Ca, Fe, Cu
النموذج الخامس أ) اللون الاسود على زرقة Mg, Si, Ca, Fe, Cu
ب) اللون الاصفر Si, Ca, Fe
وتعني Mg المغنيسيوم - Si السيليكون . Ca الكالسيوم ، Fe الحديد Cu النحاس – K البوتاسيوم . Pb الرصاص . Cr الكروم .
ص: 135

جزء من السور الشمالي لساحة القصر عند الركن الشمالي الشرقي قبل أعمال التنقيب في سنة 1981
القسم الأوسط من السور الشمالي بعد رفع الأنقاض واستظهاره الموسم 1981 - 1982.
أجزاء من السور الشمالي لساحة القصر قبل أعمال التنقيب عام 1981
بقايا السور الشمالي الساحة القصر بعد اعمال التنقيب في عام 1981
ص: 136
الصورة
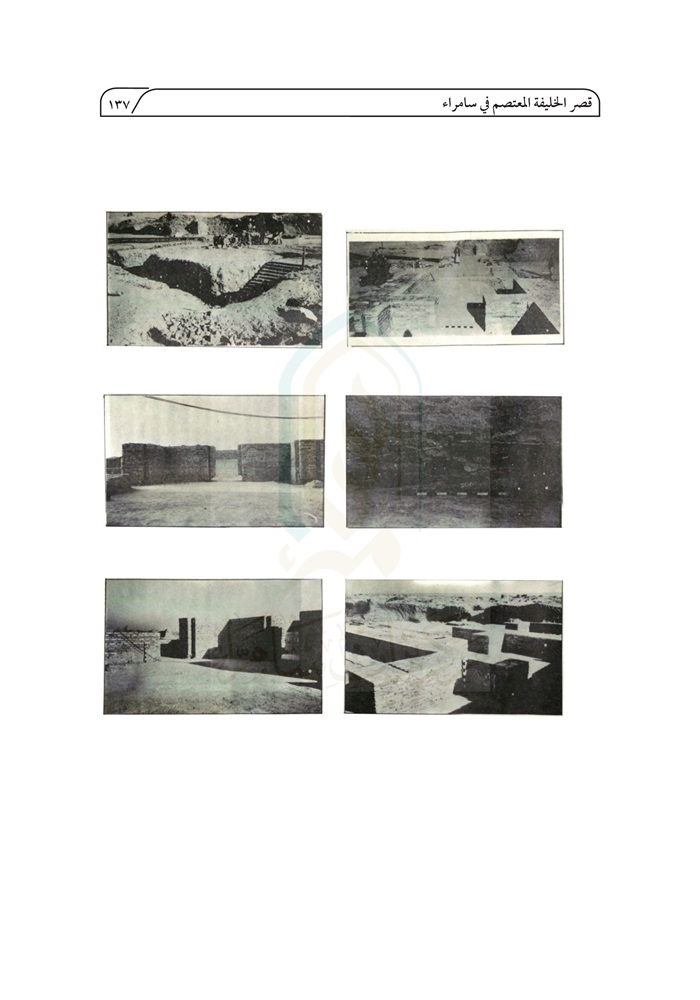
ص: 137
الصورة
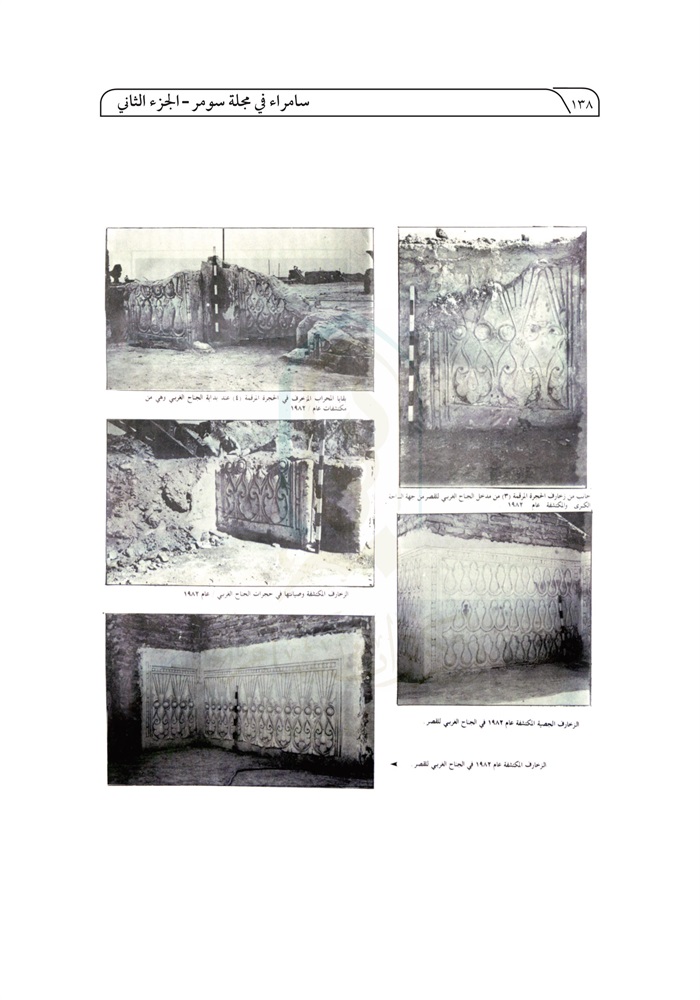
ص: 138
الصورة
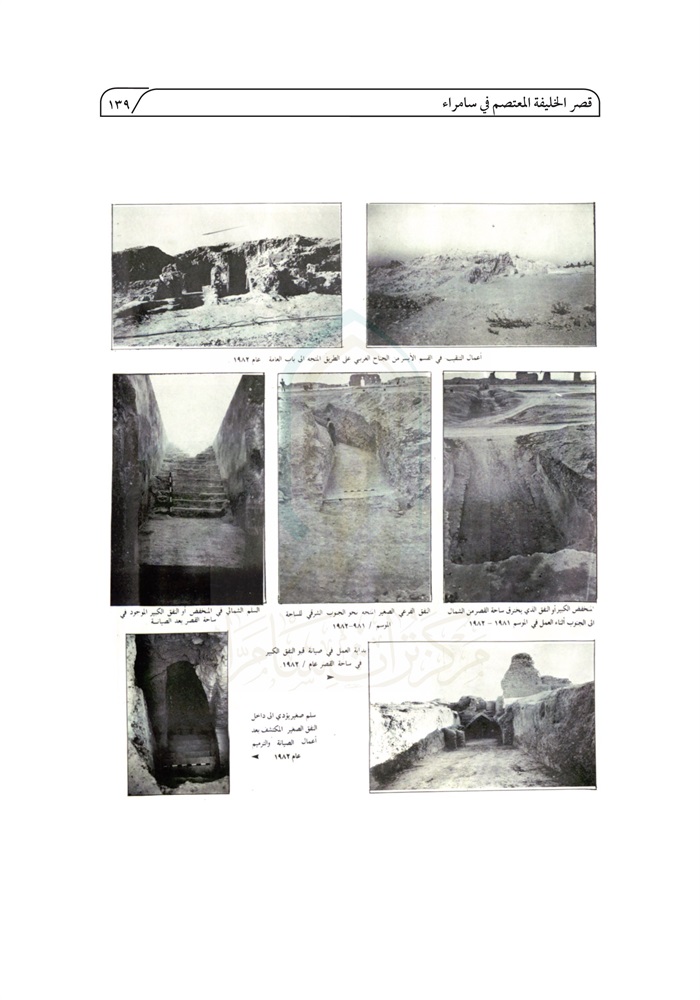
ص: 139
الصورة
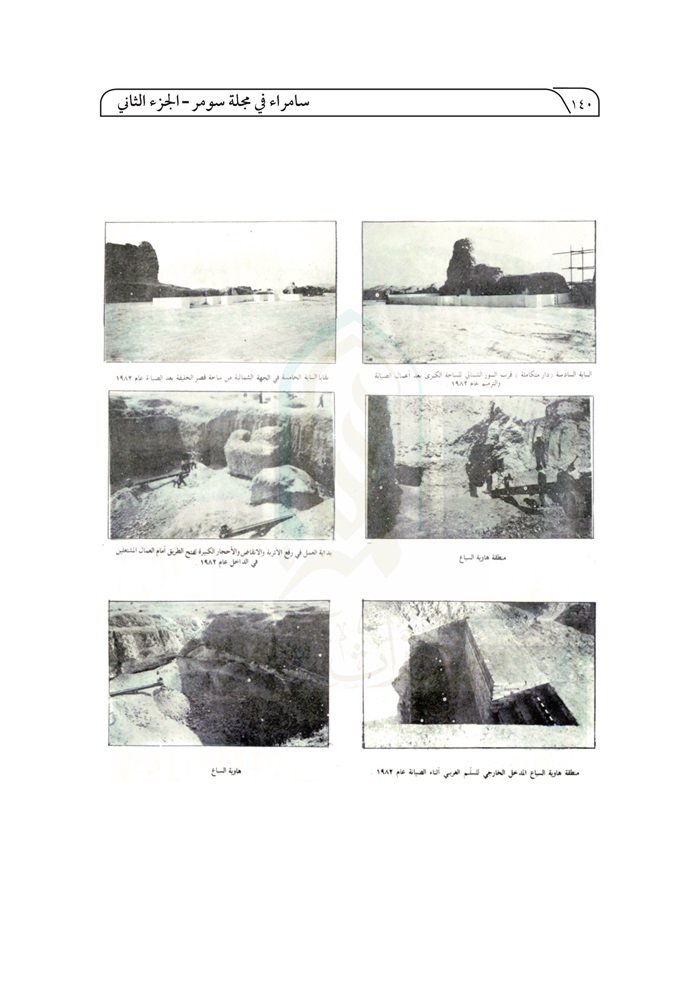
ص: 140
الصورة
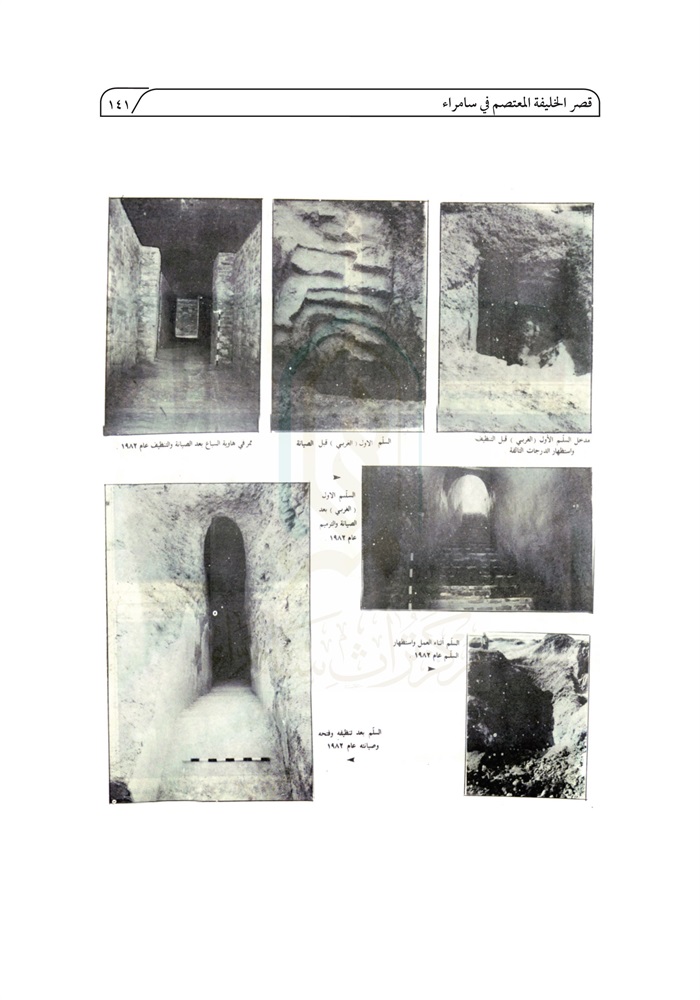
ص: 141
الصورة
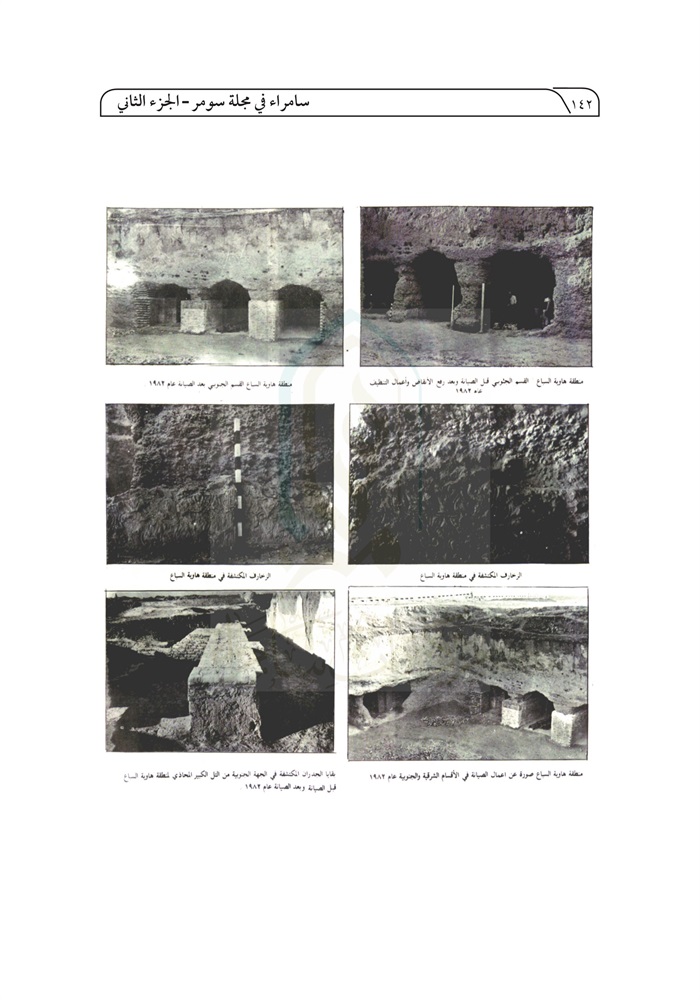
ص: 142
الصورة
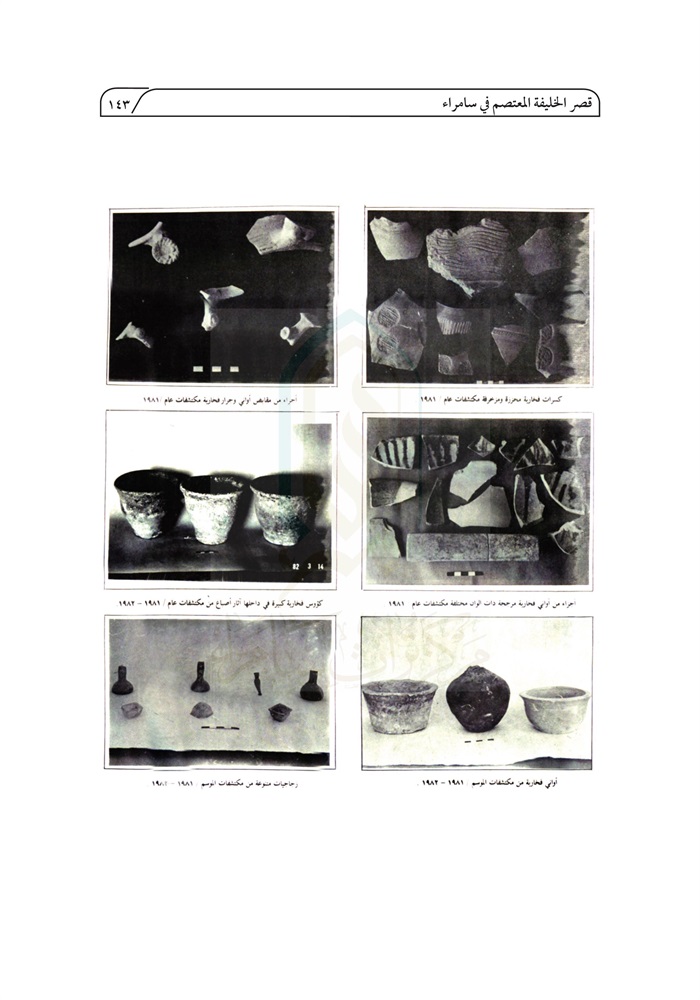
ص: 143
الصورة
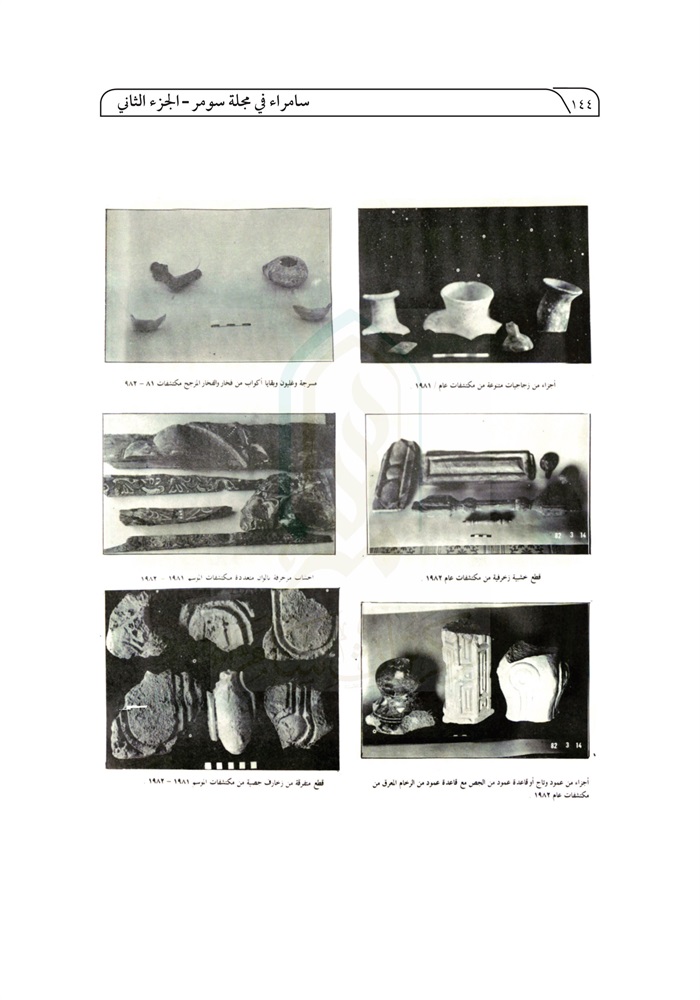
ص: 144
الصورة
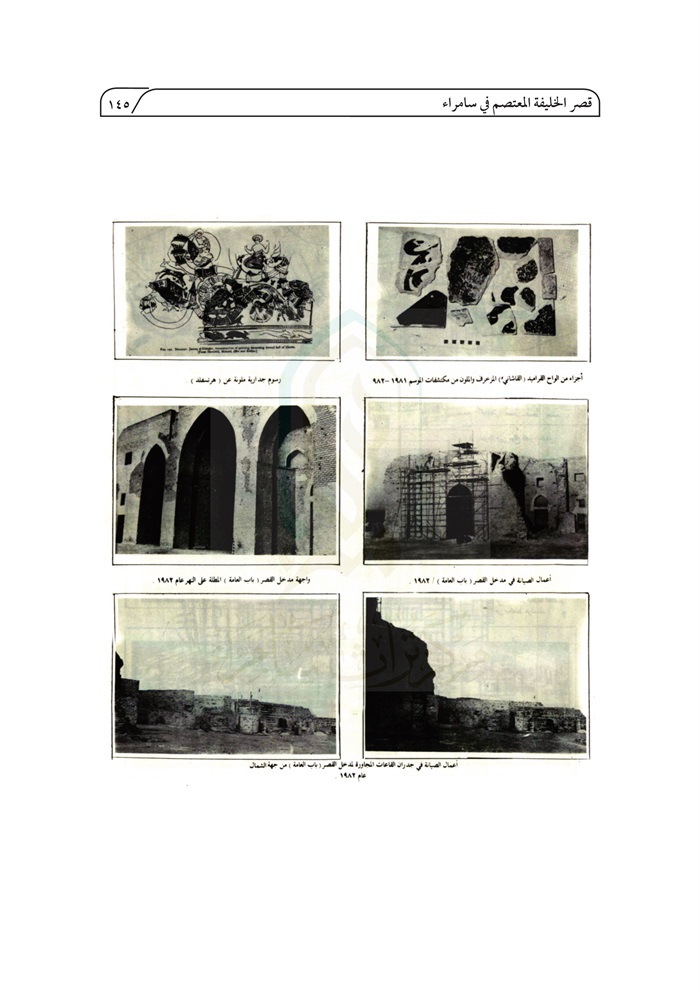
ص: 145
الصورة
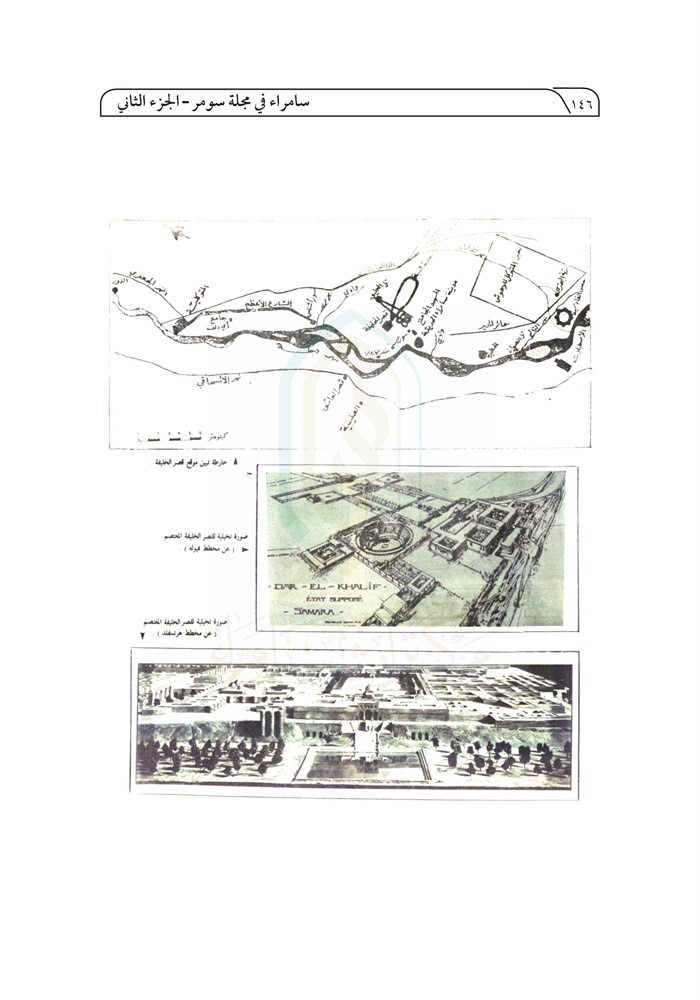
ص: 146
الصورة

ص: 147
الصورة
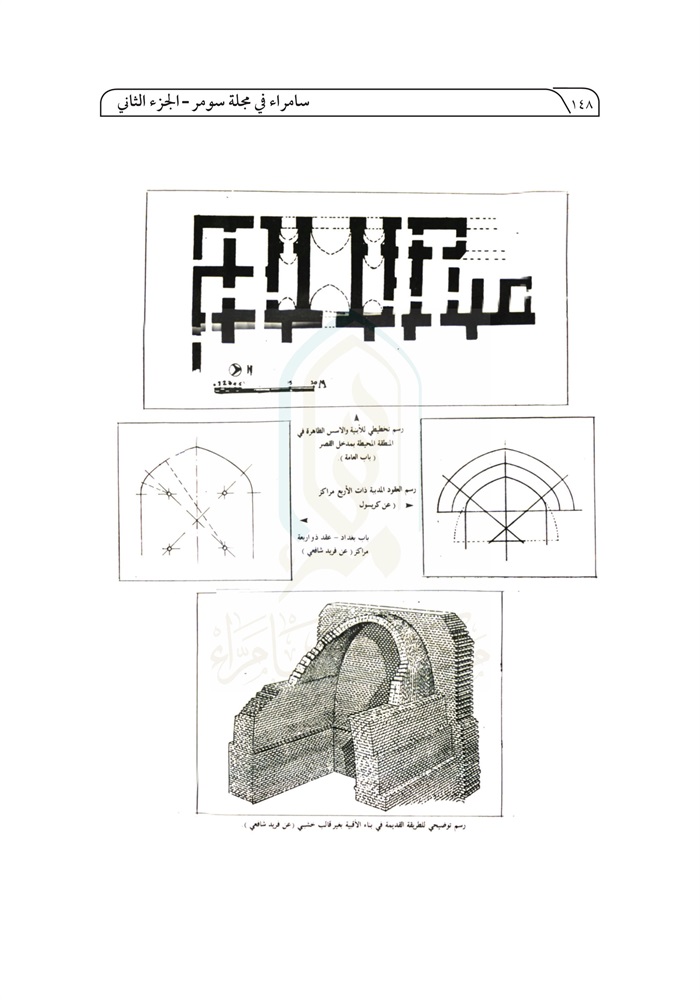
ص: 148
الصورة

ص: 149
الصورة
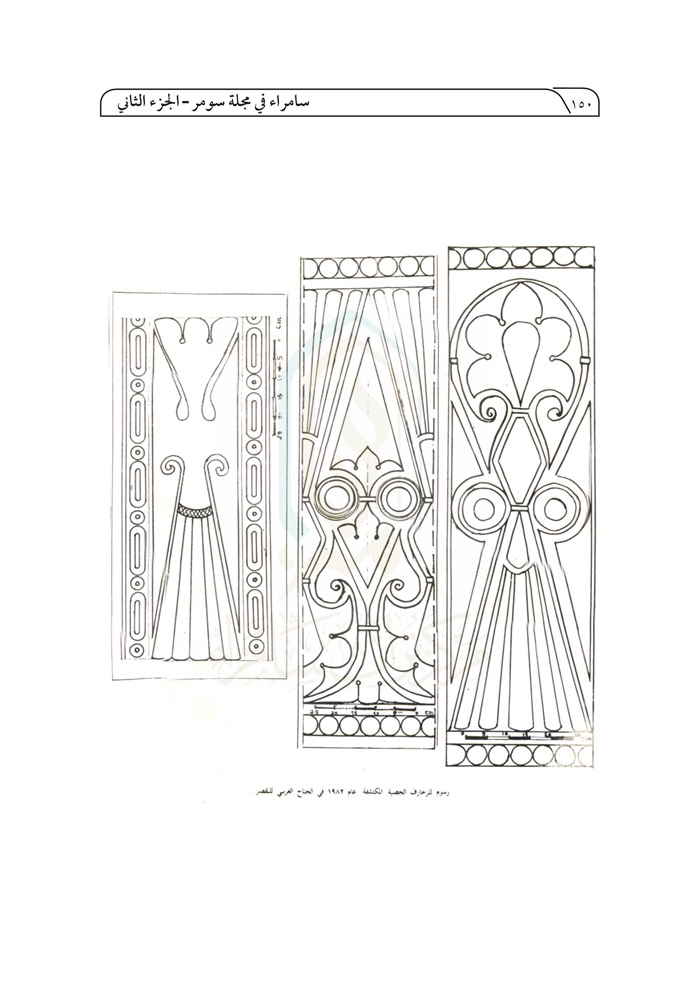
ص: 150
الصورة

ص: 151
الصورة
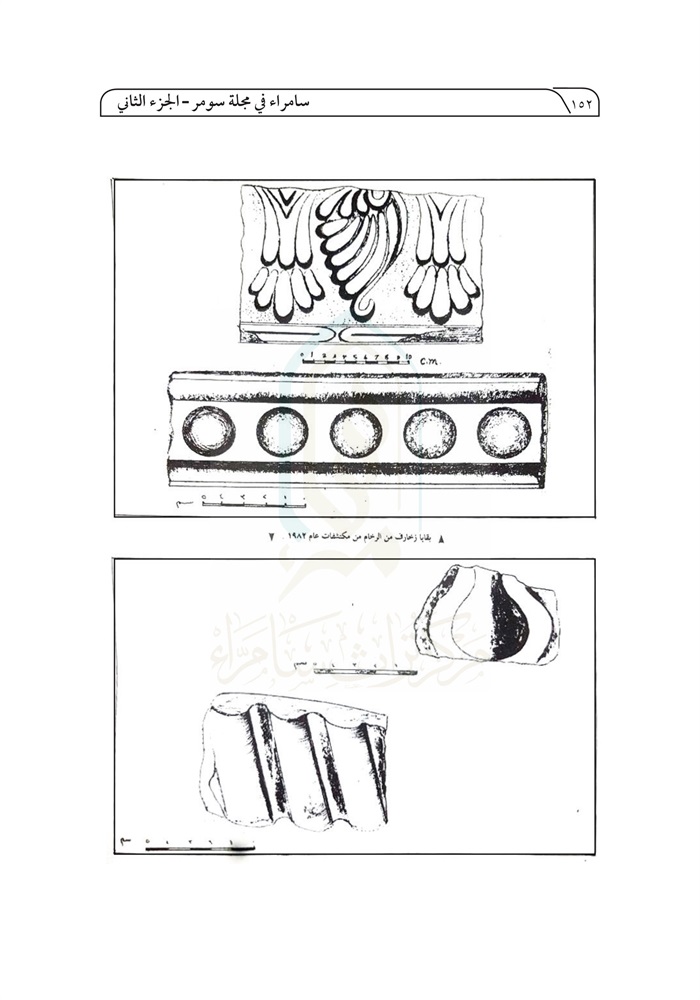
ص: 152
الصورة

ص: 153
الصورة
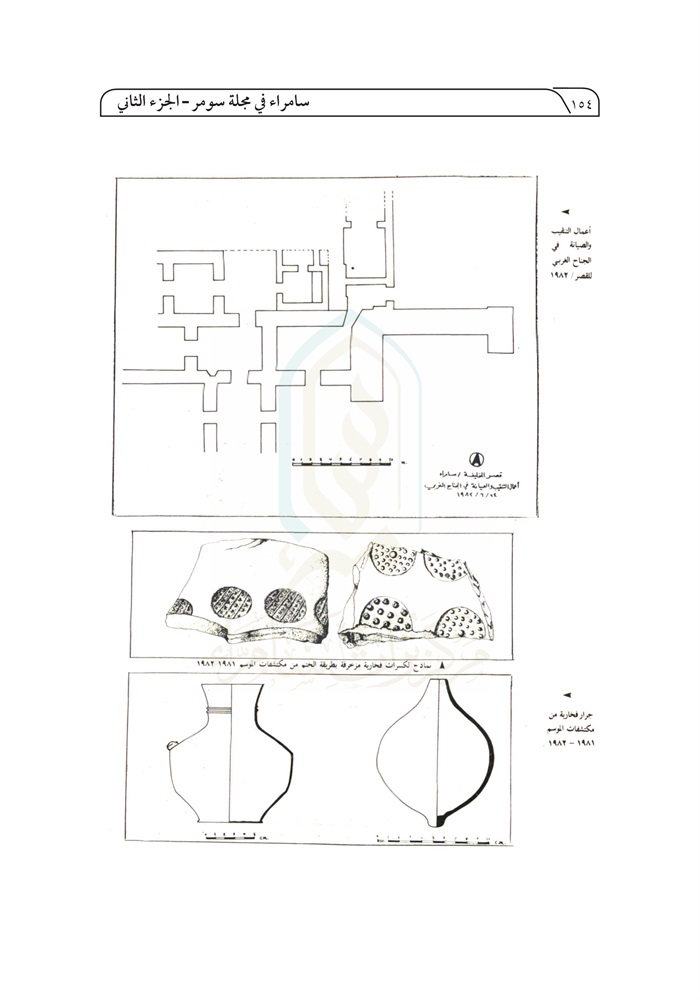
ص: 154
الصورة
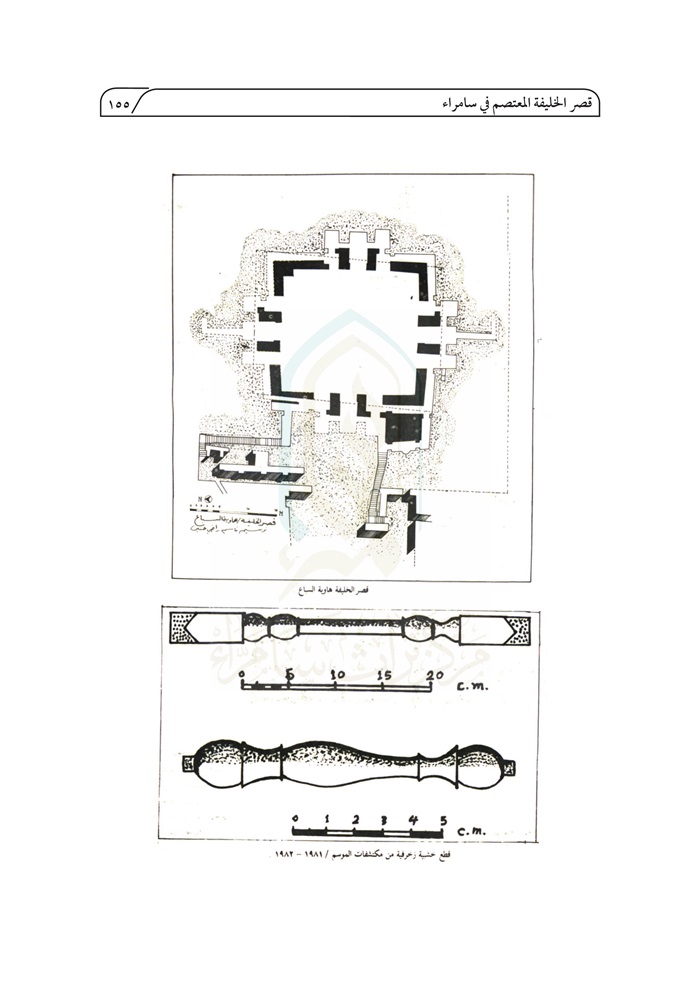
ص: 155
الصورة
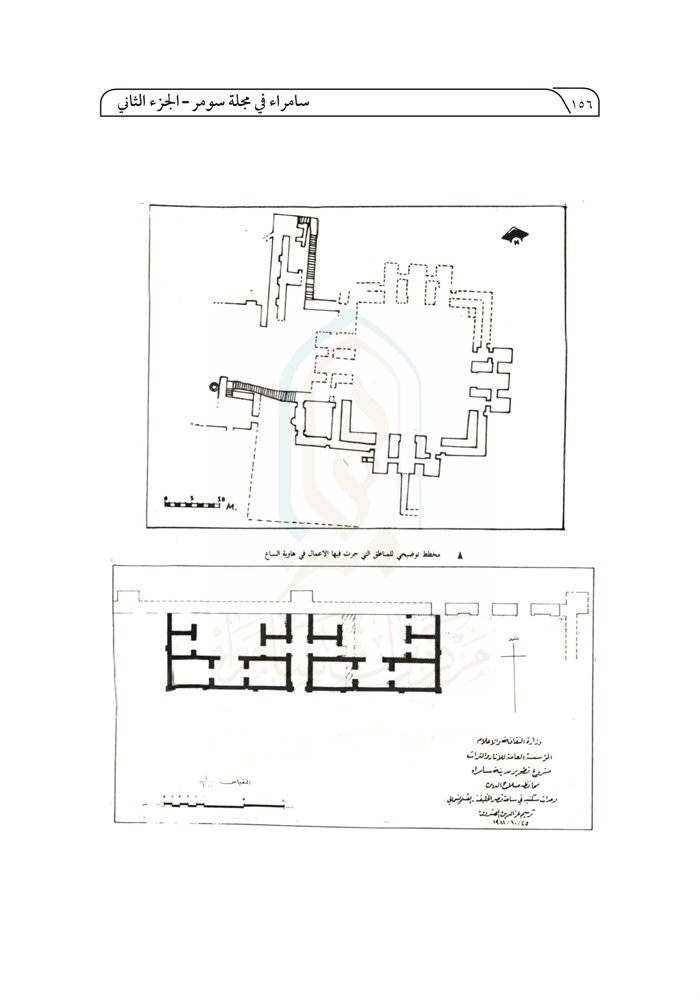
ص: 156
الصورة
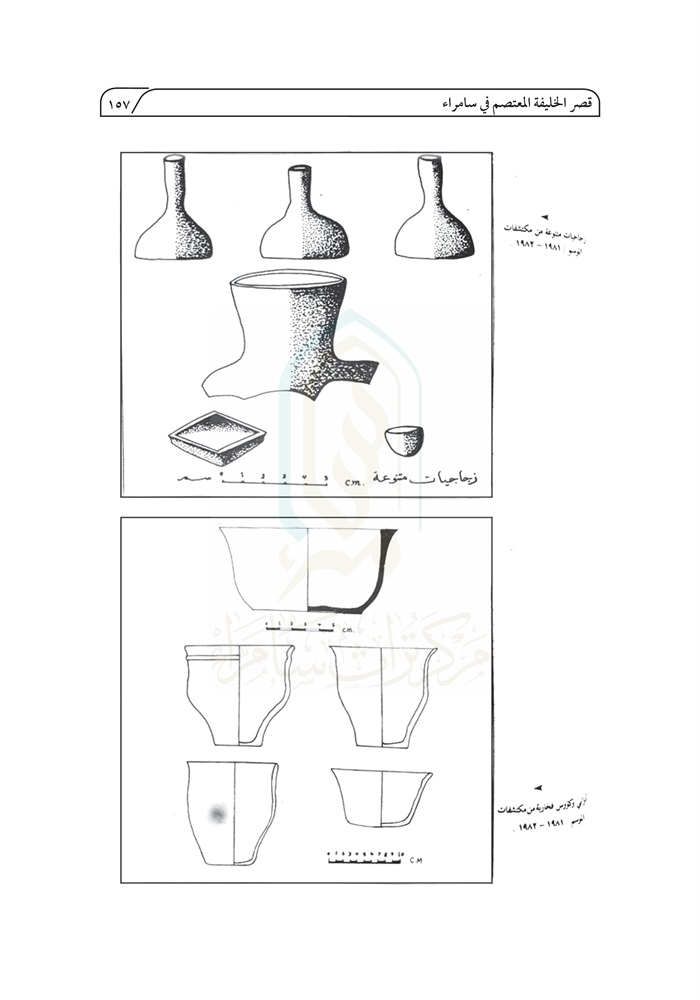
ص: 157
ص: 158
الجزء الأول والثاني المجلد الثامن والثلاثون سنة 1982
صادق عبد الحميد الراوي
مركز بحوث البناء
المقدمة:
بناء على طلب المؤسسة العامة للآثار والتراث ( مشروع تطوير مدينتي سامراء والمتوكلية الاثريتين ) بكتابها المرقم 179 في 26 / 1 / 1982 وكتابها المرقم 536 في /1982/3/17 فقد تم القيام بزيارة المواقع الأثرية في منطقة سامراء، بغية الاطلاع على المباني الأثرية، والتعرف على المواد البنائية لها. على ضوء ما تقدم تم الطلب من قسم الصيانة ارسال عينات من مواد المباني الأثرية، ومواد اولية متواجدة في الموقع وقد تم تجهيزنا ب (14) عينة من المواد الانشائية المستعملة قديماً، ونموذجين من المواد المتواجدة في الموقع نفسه.
كما تمت مناقشة مسؤول قسم الصيانة حول المباني التي يراد ادامتها خلال الفترة الحالية، وقد تبينت حسب الخطة الموضوعة من قبلهم أهمية إدامة وترميم سور عیسى، حيث العمل جار فيه حالياً وقد اقترحت ارسال عينات ممثلة للمواد الأولية التي يراد استخدامها بغية دراستها لتحديد نسب الخلط، لإيجاد افضل نسبة لذلك من ناحية القوة والمتانة وقد تفضلوا بإرسال نماذج من الجص والحصى ومادة من الموقع نفسه.
ص: 159
وتشمل هذه الدراسة تحديد مكونات المواد المرسلة من الناحيتين الكيمياوية والمعدنية، باستخدامك طرق تحليل مختلفة، كذلك تحضير نماذج من هذه المواد، ونسب خلط مختلفة بغية الوصول الى احسن الخلطات من ناحية قوة التحمل. ومقاومة الانضغاط عند الغمر في الماء. لكي يمكن الاسترشاد بها عند اجراء الترميمات والصيانة لهذه الأثار.
التجارب والنتائج:
1 - المواد المستخدمة:
-مواد انشائية من الجبس والركام الخشن والناعم في مباني الأثار.
-مواد انشائية من جدران مباني الآثار من الطين (لبن).
-الجبس (جص).
-رکام خشن (حصي) من نفس المنطقة
-مادة جبسية من مباني الأثار تستخدم كمادة مالئة تم غربلها في الموقع.
2 - التركيب المعدني للمواد الانشائية والمواد الأولية:
لقد تم تعيين التركيب المعدني لمواد الصيانة موضوع دراستنا باستخدام مجموعة عمليات تحليل حراري تفاضلي (الشكل رقم (1)). وباستخدام جهاز الأشعة السينية وقد تبين بان المكونات المعدنية هي:
-تحتوي النماذج رقم (1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16) على نسبة عالية من معدن الجبس( H2 O2 – CaSO4) ونسب مختلفة الكاربونات (CaCO3) والكوارتز (Sio2) بالاضافة إلى معادن الطين (الكاثولينات والمونتمورلو نايت والالايت) جدول رقم (1).
ص: 160
-تحتوي النماذج رقم (6 و 9 و 14) على نسب عالية من المعادن الطينية (كاولينات، مونتمورلونايت، الالابت) بالاضافة إلى الكوارتز (Sio2) والكاربونات (Caco3) والفلدسبار. جدول رقم (1).
-المنحني رقم (1) يمثل نموذج الجص وقد بين التحليل الحراري الفاضلي احتوائه على معدن البورك (CaSo4 H2 O) والجص اللامائي (CaSO4) مع احتوائه على كمية قليلة من الجبس (CaSO4 – 2H2 O) والمواد العضوية وقليل من الطين وحجر الكلس ( 3Caco) .
-كما بين المنحني رقم (2) في الشكل رقم (1) ان المادة المالكة تتكون اساساً من معدن الجبس (CaSO4 – 2H2 O) مع نسب متفاوتة من معادن الطين والمواد العضوية اضافة الى حجر الكلس ( Caco3).
3- المكونات الكيمياوية:
تم تعيين المكونات الكيمياوية بطريقة جهاز التحليل الطيفي بالأشعة السينية والجدول رقم (2) بين نتائج هذا التحليل.
كما وتم تعيين النسبة المئوية للفقدان الحريق والكبريتات بطريقة التحليل الكيمياوي لإيجاد النسبة المئوية للجبس الجبس اللامائي وكاربونات الكالسيوم . والمغنيسيوم والجدول رقم (3) يبين نتائج هذا التحليل.
4- الاختبارات والنتائج:
على ضوء ما تقدم فقد تم عمل 4 مكعبات 5×5×5 سم لكل خلطة وفق نسب الخلط المكونة من الجص والحصى والمادة المالئة او الرمل او الطين كما وتم حرق المادة المالئة على درجة حرارة ( 150 - 200 ) م لمدة 24 ساعة العمل 4 مكعبات بنفس الأبعاد السابقة وقد اضيف الماء بنسبة %60 بالنسبة الى الجص لكل الخلطات.
وقد تم ايجاد قوة التحمل لثلاثة مكعبات وتأثير الغمر في الماء لمدة 24 ساعة
ص: 161
على قوة تماسك النماذج والجدول رقم (4) يبين نسب الخلط والنتائج التي تمالحصول عليها .
وقد تم تقسيم درجة التأثير بالغمر في الماء الى اربع درجات: عديم التأثير، بطيء التأثير، متوسط التأثر . سريع التأثر.
5- مناقشة النتائج:
عند اضافة الماء إلى المواد المخلوطة وفق النسب المطلوبة يتحد الماء كيمياوياً مكونات الجص الفعال مكوناً معدن الجبس (CaSO4 – 2H2 O) الذي يتصلب خلال فترة زمنية أقل من 20 دقيقة وينتج عن ذلك جسم متماسك يمثل الجبس المادة الرابطة التي تعمل على ربط المواد المالئة المضافة للخلطة بعد عملية التصلب تفتح القوالب لاخراج النماذج وتوضع مباشرة في فرن عند درجة حرارة 45م لمدة 24 ساعة لتجفيفها ثم يجري عليها فحص قوة التحمل وتأثير الغمر في الماء لمدة 24 ساعة.
-مقاومة الانضغاط: يتضح من النتائج في الجدول رقم (4) بان مقاومة الانضغاط للخلطات ارقام (8 و 9 و10) تتراوح بين 80-70كغم / سم2 وهي اعلى ما امكن الحصول عليه من خلال الخلطات موضوع الدراسة وذلك عكس الخلطات ارقام (1 و 2 و 6 و 14) والتي تتراوح قوة التحمل فيها بين (25-54) كغم/ سم2 او المخططات ارقام (3ز. 13 و 12 و 11 و 7 و 5 و 4) فكانت متوسطة المستوي من حيث مقاومة الانضغاط. حيث تراوحت بين (50-26) كغم/ سم2 ويعزى ارتفاع قوة التحمل في الخلطات المجموعة الأولى إلى عدم وجود المادة المالئة التي بينها التحليل المعدني بانها تتكون أساسا من الجص المائي والطين وهي مواد تتميز بانخفاض قوة تماسكها تحت الظروف التي أجريت عليها التجارب. اما في المجموعتين الثانية والثالثة فقد انخفضت معدل قوة التحمل بصورة موازية لزيادة نسبة المادة المالكة
ص: 162
فى الخلطات
-تأثر العمر في الماء: في الجدول رقم (4) بين بان تأثر النماذج عند الغمر في الماء يأتي موازيا مع زيادة او نقصان معدل قوة التحمل. اي تزداد مقاومة النماذج بالغمر بأزد باد قوة التحمل والعكس صحيح. ويقل المعدل بانخفاض معدل القوة. ويمكن أن يعزي ذلك ايضا لزيادة نسبة المادة المالئة التي ليس لها القدرة على التماسك عند الغمر في الماء.
ص: 163
الصورة

ص: 164
الصورة

ص: 165
الصورة

ص: 166
التوصيات:
بناء على ما تقدم نوصي بما يلي:
1- يمكن استخدام الخلطات رقم (8 و 9 و 10) للحصول على احسن النتائج.
2- يمكن استخدام الخلطات رقم (4 و 5 و 7 و 11).
3- يمكن استخدام الخلطات رقم (3 و 12 و 13 و 14)
4- لا نوصي باستخدام الخلطات رقم (1 و 2 و 6) وذلك للأسباب، التي تم ذكرها سابقا فقرة.
في حالة تطبيق توصية رقم (1) بعد دراسة جدواها الاقتصادية. يمكن اضافة مادة ملونة بنسبة قليلة لتكون متجانسة مع لون الجدار الأصلي. ونقترح استخدام حجر الكلس المعجون لهذا الغرض وبنسب مدروسة . اما اذا اريد استخدام المادة المالئة فيمكن ذلك بعد اعادة تنشيطها. وذلك بواسطة تسخينها عند درجة حرارة تتراوح بن 150 - 200م.
ملحق يبين ارقام النماذج ومواقعها
1- نقطة رقم (2) الشارع الأعظم غطاء ارضية وجدران الحجرة رقم (20).
2- نموذج من جدار خندق محفور من قبل الزراعة في منطقة قصر الخليفة.
3- نقطة رقم (1) الشارع الأعظم عينة من الجدران الداخلية غرفة قرب الحمام.
4- نقطة رقم (2) الشارع الأعظم عينة من جدران داخلية.
5-سور عيسى الجزء الأسفل.
6- عينة تراب من منطقة أرض مجاورة الى تل العليج القشرة الأرضية.
7- خليط عينة من بناء الجزء الأعلى من سور اشناس.
ص: 167
8- الجزء الأسفل من الجدار الداخلي لسور اشناس
9- نقطة رقم (2) الشارع الأعظم لبنة من احد الجدران الداخلية الوحدة البنائية الرابعة الحجرة رقم (16).
10- نقطة رقم (2) الشارع الأعظم بياض الجدران الداخلية.
11- نقطة رقم (2) الشارع الأعظم عينة من جدران الساحة المركزية.
12- سور عيسى الجزء الأعلى ابتداء من ارتفاع 2م فوق مستوى الأرض 13 - قطع جصية رابطة في السور الشمالي لقصر الخليفة.
13- لبنة من السور الشمالي القصر الخليفة .
14- عينة من الجزء الأسفل من سور اشناس.
15- نموذج من جدار قصر الخليفة خلف السور الشمالي
بغداد / 1982
ص: 168
الجزء الأول والثاني / المجلد الثامن والثلاثون سنة 1982 م.
علاء الدين أحمد نجم العاني
ماجستیر آثار
1 - «القصر المعشوق»: تأريخه
من مباني سامراء العباسية التي تدل على عظمة وجلال، والتي خلصت إلينا بقايا منها، أطلال قصر يقع على جانب دجلة الغربي، غير بعيد عن قبة الصليبية، إنه قصر المعشوق، آخر ما شاده خلفاء بني العباس من قصور حاضرتهم الثانية سر من رأى.
وبديهي أن يكتسب قصر المعشوق أهمية خاصة من لدن الباحثين في عمارة سامراء وفنونها، لتمثيله فنها العماري والزخرفي، ويبدو لي أنه لو قدر وتم الكشف عن طابقه الأرضي بإزاحة ورفع الأنقاض والأتربة التي تراكمت فيه، كانت خير حافظ له من عبث الإنسان والزمن على حد سواء.
وبقدر تعلق الأمر بموضوعنا، سأتناول فيه تاريخ القصر، ذلك أنه لم يتسن لأحد من الباحثين توريخه بشكل مقنع، أقول : إنه من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ القصر بشكل قاطع بحيث يمكننا القول إنه في سنة كذا كان البدء بالبناء، وفي سنة كذا كان الفراغ منه؛ ذلك لأن النصوص التاريخية لا تعيننا، ومهما يكن من أمر فإنه بالإمكان إعطاء تاريخ تقريبي للبدء بالبناء والفراغ منه من خلال تحليل النصوص التاريخية والأدبية ومقارنتها.
ص: 169
ليس هناك ثمة شك في كون المعشوق من أبنية الخليفة المعتمد على الله الذي تولى الخلافة سنة 256ه_، وتوفي سنة 279ه_، ذلك لأن المؤرخين مجمعون على ذلك.
حاول البعض من الباحثين توريخ القصر بسنة 264ه_ (1)معتمدين في ذلك على حادثة انتقال الخليفة المعتمد على الله من جانب سامراء الشرقي إلى الغربي، الذي يقع فيه القصر، إثر النزاع الذي نجم بين الخليفة وأخيه الموفق، يقول الطبري في حوادث سنة 264 ه_: ( وفي هذه السنة خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامراء ومعه الحسن بن وهب وشيعه أحمد بن الموفق ومسرور البلخي وعامة القواد فلما صار بسامرا غضب عليه المعتمد وحبسه وقيده وانتهب داره وداري أبنيه وهب وإبراهيم واستوزر الحسن بن مخلد لثلاث بقين من ذي القعدة، فشخص الموفق من بغداد ومعه عبد الله بن سليمان، فلما قرب أبو أحمد من سامرا تحول المعتمد إلى الجانب الغربي فعسكر فيه، ونزل أبو أحمد ومن معه جزيرة المؤيد واختلفت الرسل بينهما ، فلما كان بعد أيام خلون من ذي الحجة صار المعتمد إلى حراقة في دجلة وصار إليه أخوه أبو أحمد في زلال فخلع على أبي أحمد وعلى مسرور البلخي وكيغلغ واحمد بن موسى بن بغا، فلما كان يوم الثلاثاء لثمان خلون من ذي الحجة يوم التروية عبر أهل عسكر أبي أحمد إلى عسكر المعتمد وأطلق سليمان بن وهب ورجع المعتمد إلى الجوسق ...) (2)،
ص: 170
وهذه الحادثة فيما أرى مثلها مثل استنفار الخليفة المعتصم بالله لجيشه سنة 223 ه_ عند عزمه على غزو عمورية، يقول اليعقوبي (... فلما انتهى الخبر إلى المعتصم قام من مجلسه نافراً، حتى جلس على الأرض، وندب الناس للخروج، ووضع الأعطاء، وعسكر من يومه بموضع يعرف بالعيون من غربي دجلة ) (1)، ويؤكد المسعودي ذلك قائلاً: (فخرج المعتصم من فوره نافراً عليه دراعة من الصوف بيضاء، وقد تعمم بعمامة الغزاة، فعسكر غربي دجلة) (2).
ومعروف أن معسكر الخليفة المعروف بالإصطبلات (3) يقع في الجانب الغربي من دجلة، إضافة إلى قصر الجص (4) أحد قصور الخليفة المعتصم بالله، ويبدو لي أن لا
ص: 171
علاقة بین هذه الحادثة و بین قصر المعشوق.
الصورة

والذي أراه أن البدء بالبناء كان قبل سنة 263 ه_ ان لم يكن فيها استناداً إلى قول الصابي في محمد بن عبد الله بن يحيى بن خاقان: (كان أبو علي أكبر ولد أبيه، وتولى بعد وفاته ديوان زمام الخراج والضياع السلطانية في وزارة الحسن بن مخلد، فلما صرف الحسن وتقلد سليمان بن وهب قلّده نفقات أبنية المعتمد على الله بالمعشوق في الجانب الغربي الذي من سر من رأى ثم صرفه المعتمد) (1)، ففي 263 ه_ توفي عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزيراً للمعتمد على الله (2)، (واستوزر من الغد الحسن بن
ص: 172
مخلد) (1)، غير أنه لم يمكث في الوزارة إلا (نيفاً وعشرين يوماً) (2) حسب قول المؤرخ ابن الكازورني، والسبب كما يقول الطبري في حوادث سنة 263ه_: (قدم موسى بن بغا سامرا لثلاث بقين من ذي القعدة، فهرب الحسن بن مخلد إلى بغداد، واستوزر مكانه سليمان بن وهب ) (3) الذي قلده نفقات أبنية المعتمد على الله بالمعشوق. ويبدو أنه لم يستمر طويلاً في عمله، وربما كان علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم قد حل محله مباشرة بعد عزله عن نفقات أبنية المعشوق، يقول ياقوت الحموي في ترجمة ابن المنجم : (ثم أفضى الأمر إلى المعتمد على الله، فحلّ منه محله ممن كان قبله من الخلفاء وقدمه على الناس جميعاً، ووصله وقلده ما كان يتقلد من أعمال الحضرة) (4). ويضيف قائلاً: (وقلده بناء المعشوق، فبنى له أكثره ) (5)، وكانت وفاة ابن المنجم سنة 275 ه_ (6)، فهل هذا يعني أنه توفي والبناء بعد لم يتكامل بعد أن بنى له أكثره، أم أنه تسلّم العمل بعد ما بدئ به، فأتم هو أكثره وأنجز على يديه قبل وفاته؟
يبدو لي الاحتمال الثاني أكثر رجحاناً؛ ذلك أن النصوص التي وصلتنا يستشف منها تكامل القصر قبل هذه السنة، فالشاعر محمد بن إسحاق الصيمري، المتوفى أيضاً في سنة 275 ه_(7) ، يقول عنه ياقوت الحموي : عاش إلى أيام المعتمد ودخل في ندمائه، وله يهجو طباخ المعتمد.
يا طيب أيامي بمعشوق *** و نحن في بعد من السوق
ص: 173
إذا طلبت الخبز من فارس *** ينفخ لي صالح بالبوق(1)
ويقول اليعقوبي: (وولي أحمد المعتمد بن المتوكل، فأقام بسر من رأى في الجوسق وقصور الخلافة، ثم انتقل إلى الجانب ]الغربي ] بسر من رأى فبنى قصراً موصوفاً بالحسن سماه المعشوق، فنزله فأقام به حتى اضطربت الأمور فانتقل إلى بغداد ثم إلى المدائن ) (2). ويتوضح نص اليعقوبي هذا من خلال نصوص لآخرين من المؤرخين، فالخليفة المعتمد على الله كان كالمحجور عليه، ليس له من الخلافة إلا اسمها (3)؛ لذا نجده يروم الهرب إلى مصر والالتجاء إلى أحمد بن طولون، يقول الطبري في حوادث سنة 269 ه_: (وفيها في يوم السبت للنصف من جمادى الأولى شخص المعتمد يريد اللحاق ) (4) ، غير أن محاولته هذه باءت بالفشل، إذ يقول الطبري في حوادث نفس السنة (الأربع خلون من شعبان منها رد إسحاق بن كنداج المعتمد إلى سامرا، فنزل الجوسق المطل على الجير ) (5) ، في حين يقول البلوي: (فلما بغوا سّر من رأى تلقاه أبو العباس بن الموفق وصاعد بن مخلد فسلّمه إسحاق إليهما، وانصرف إلى دار الخليفة ينتظر عودتهم، فأنزلا المعتمد دار أبي أحمد بن الخصيب التي في طرف الجسر، ومنع من نزول الجوسق والمعشوق) (6)، مما يشعر بأن قصر المعشوق كان متكاملًا في سنة
ص: 174
269 ه_. وفي نفس السنة يقول الطبري: (كان احد إحدار المعتمد إلى واسط فصار إليها في ذي القعدة وانزل دار زيرك (1)) ، وفي سنة 270 ه_: (وللنصف من شعبان دخل المعتمد بغداد، وخرج من المدينة حتى نزل بحذاء قرطبل في تعبية، ومحمد بن طاهر يسير بين يديه بالحربة ، ثم مضى إلى سامرا ) (2).
ويبدو أن اضطراب الأمور التي تحدث عنها اليعقوبي كان في سنة 274 ه_، إذ يقول: ( وفيها دخل صديق الفرغاني دور سامرا فأغار على أموال التجار وأكثر العبث في الناس وكان صديق هذا يخفر أولاً الطريق، ثم تحول لصاً هارباً يقطع الطريق (3)). وفي سنة 275 ه_ ( تصعلك فارس العبدي، فعاث بناحية سامرا، وصار إلى كرخها فانتهت دور آل خشنج (4)) .
وفي سنة 278 ه_ يخبرنا الطبري بأن المعتمد كان مقيماً بالمدائن، وأن الموفق (وجه أبا الصقر يوم الجمعة إلى المدائن فحمل منها المعتمد وولده، فجيء بهم إلى داره) (5) . ويضيف قائلاً : (ووا فى المعتمد ذلك اليوم الذي وجه إليه في حمله، وهو يوم الجمعة نصف النهار قبل صلاة الجمعة مدينة السلام لتسع خلون من صفر (6)) .
وللشاعر البحتري (204 - 284 ه_) قصيدة في مدح الخليفة المعتمد على الله ووصف قصر المعشوق، يستشف منها أن القصر كان مكتملاً في سنة 269ه_، مما يعزز ما قلناه سابقاً. يقول واصفاً القصر :
لا زال (معشوقك) يُسقى الحيا *** من كل داني المزن واهي الخر
وقفما خلونا مذ رأيناه من *** فتحٍ جديدٍ وزمانٍ أنيقٍ
أشرف نظَّاراً إلى ملتقى *** (دجلةَ) يلقاها بوجهٍ طليق
ص: 175
وطالع الشمس على موعدٍ *** بمثل ضوء الشمس عند الشروق
لم أر (كالمعشوق) قصراً بدا *** لأعين الرائين غير المشوق
هذاك قد برَّز في حسنه *** سبقاً، وهذا مسرع في اللحوق(1)
وبدهي أن تكون القصيدة قد قيلت بعد أن سكن المعتمد على الله المعشوق، وتاريخ القصيدة، كما يراه حسن كامل الصير في محقق ديوان البحتري، هو سنة 265 ه_ (2)، غير أني لا أوافقه مثل هذا الرأي، ولنأتِ إلى بعض أبيات من القصيدة التي من خلالها نستطيع توريخ القصيدة بشكل دقيق، يقول البحتري:
فشيعة (الشاري) إلى ذلةٍ *** قد جنحوا للسلم بعد المروق(3)
وكانت وفاة الشاري مساور بن عبد الحميد الخارج على الدولة، سنة 263ه_(4) ، إذاً فالقصيدة قيلت بعد وفاته، ولما كان البحتري قد تعرض في قصيدته هذه إلى وفاة الصفار حين يقول:
ورمَّة (الصفار) متروكةً *** رهناً لإحدى علقات العلوق(5)
يقول الطبري في حوادث سنة 265 ه_: (وفيها مات يعقوب بن الليث [الصفار[ بالأهواز ، وخلفه أخوه عمرو بن اللیث، وكتب عمرو إلى السلطان بأنه سامع له ومطيع ) (6) ، فليس من المنطق والمعقول أن تكون القصيدة قيلت في نفس السنة التي توفي فيها الصفار، علاوة على ذلك فإن الشاعر البحتري يضيف قائلاً:
وحائن (البصرة) عند التي *** تخشى عليه لاحج في مضيق
ينوي فراراً لو يرى مَخْلَصَاً *** من سببٍ يفضي به أو طريق (7)
ص: 176
ويقول الطبري: (وكان خروج صاحب الزنج في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة 255 ، وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة 270) (1). ولكن متی أصبح صاحب الزنج في مأزق لا يستطيع الخروج منه والفرار من المصير المحتوم الذي ينتظره؟ يبدو لي ذلك في سنة 269 ه_، حيث يقول الطبري في حوادث هذه السنة: ( فلما نزل الخبث من الحصار ما نزل، وتفرق عنه أصحابه وضعف أمره شمر في الحيلة للخلاص) (2) . ويقول ابن الداية: (توالت الأخبار من الحضرة أن الناجم بالصرة قد شارف القبض عليه في آخر سنة تسع وستين ومائتين) (3). وعليه فإن القصيدة قيلت سنة 269 ه_.
من كل ما تقدم، يبدو لي أن أنسب فترة يؤرخ بها القصر المعشوق هي :
البدء بالبناء سنة 263 ه_، والفراغ منه كان سنة 268 ه_.
ويتمتع المعشوق بموقع إستراتيجي ممتاز ، ذي طبيعة عسكرية، إذ إنه شيد على ربوة عالية، بحيث يشرف ويسيطر على الطريق الواصل بين بغداد - الموصل، هو فيما أرى أقرب إلى الحصن منه إلى القصر. وبعد أن هجرت سامراء، واستعادت بغداد مركزها السابق كحاضرة للخلفاء العباسيين، لم تنقطع أخبار المعشوق، ورغم أن تلك الأخبار نزرة للغاية، إلا أنها تعطينا صورة عن تلك الاستخدامات التي استخدم بها. ففي سنة 320 ه_، عندما خرج أمير الأمراء مؤنس المظفر من بغداد متوجهاً نحو الموصل مغاضباً الخليفة المقتدر بالله، وبعد أن بسط سيطرته على الموصل، غادرها عائداً في نفس الطريق الذي سلكه، يقول مسكويه : وكان المقتدر قد وجه أبا العلاء سعيد بن حمدان وصافياً البصري في خيل إلى سر من رأى، ثم أنفذ أبا بكر محمد
ص: 177
بن ياقوت في ألفي فارس ومعه غلمان الحجرية إلى المعشوق) (1). ويضيف ابن الأثير قائلاً : (فلما وصل مؤنس إلى تكريت أنفذ طلائعه، فلما قربوا من المعشوق جعل العسكر الذين مع ابن ياقوت يتسللون ويهربون إلى بغداد). (2)
وعندما عزم معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه الديلمي على بناء دار له ببغداد سنة 350ه_ ، نقضت قصور الخلفاء بسامراء (3) لاستخدام موادها في بناء تلك الدار. ويقول ابن الجوزي: (ونقض المعشوق بسر من رأى وحمل آجره). (4)
ولما اجتاز عماد الدولة أبو العلاء رافع بن يحيى الدولة مقبل بن بدران العقيلي أمير العرب بالمعشوق، توقف، فكتب عليه من نظمه:
مررت على المعشوق والدمع سائح *** على صحن خدي ما أطيق له ردا
فقلت له أين الذين عهدتهم *** يقضون عيشاً في زمانهم رغدا
فقال: مضوا واستخلفوني كما ترى *** وبادوا فما يخشون حراً ولا بردا(5)
وعند المعشوق، في سنة 526 ه_ هزم عماد الدين زنكي، يقول ابن خلدون (سار قراجا الساقي إلى مدافعة زنكي، فدافعه على المعشوق فهزمه) (6) ويقول ابن الأثير: (... وسار يوماً وليلة إلى المعشوق وواقع عماد الدين زنكي فهزمه وأسر كثيراً من أصحابه، وسار زنكي منهزماً إلى تكريت) (7) .
ص: 178
وفي حوادث سنة 602 ه_، يقول ابن الساعي: (قتل الأمير سنجر بن مقلد بن سليمان بن مهارش أمير عبادة بأرض المعشوق، قتله أخوه علي وذلك في شعبان هذه السنة ) (1) .
وخلاصة ما أراه بالنسبة للمعشوق، هو أن الخليفة المعتمد على الله كان يرمي من بنائه في الجانب الغربي، وفي مثل هذا الموقع الحصين، إضافة إلى التحصينات الدفاعية التي أحيط بها، إلى استعادة هيبته كخليفة، بعد أن حجر عليه الموفق، ولم يعد له من الخلافة إلا اسمها، ولم يهجر المعشوق بعد عودة الخلافة إلى بغداد، فالذين استقروا فيه أضافوا إلى البناء الأصل إضافات كثيرة من السهولة بمكان التعرف عليها، ويبدو أنهم استخدموه لأغراض عسكرية، استناداً إلى النصوص التاريخية التي ،أوردناها، علاوة على ذلك فإن كلاً من الرحالتين ابن جبير (2) وابن بطوطة (3)أسمياه بالحصن، مما يجعلني أؤكد أن المعشوق أقرب إلى الحصن منه إلى القصر، غير أن هذا لا يعني أن المعشوق لم يستوطن من قبل أناس آخرين، فعندما رآه ياقوت الحموي المتوفى سنة 626 ه- كان يقطنه قوم من الفلاحين يقول عنه ياقوت: (قصر عظيم بالجانب الغربي من دجلة، قبالة سامراء في وسط البرية، باقٍ إلى الآن، ليس حوله شيء من العمران يسكنه قوم من الفلاحين، إلا أنه عظيم مكين محكم، لم يبن في تلك البقاع - على كثرة ما كان هنالك من القصور – غيره»(4).
ص: 179
ص: 180
المجلد التاسع والثلاثون سنة 1983 م.
علاء الدين أحمد نجم العاني
ماجستير آثار
(1) أضواء على باب العامة في سامراء
كثيراً ما كنت أمعن النظر، وأقلب الطرف في البناية التي تعارف على تسميتها
الباحثون باسم باب العامة في سامراء، وكنت دائم التردد في قبول مثل هذه التسمية أتساءل هل إنه حقاً باب العامة الذي كان أبرز جزء في دار العامة؟ ذلك الذي اشتهر في تأريخ سامراء، بأنه موضع صلب الخارجين على الدولة، وعنده كان يتجمهر الجمهور ليشاهد ما تريد الدولة أن تريه إياه، فأجدني غير مقتنع بذلك، رغم أني قلبت الأمر من جميع جوانبه.
ومما يؤسف له، أن باحثينا (1)كثيراً ما يخلطون بين دار الخلافة، التي هي دار
ص: 181
العامة، حيث تسمى أيضاً دار السلطان والتي يؤلف باب العامة أبرز أجزائها، وبين قصر المعتصم بالله المعروف بالجوسق الخاقاني، فكأن البنايتين في نظرهم بناية واحدة، مع تعدد أسمائهما، وثاني الأمور التي يؤسف لها، أنهم ، أعني باحثينا، يعتمدون دون تمحيص، على ما هو شائع عند العامة من أسماء للعمائر التي خلصت إلينا، وإن كان مثل ذلك في بعض الأحيان، الدليل الذي يوصلنا إلى الحقيقة التي نطمح إليها، غير أنه لا يمكن أن يكون الفيصل في مثل هذه الأمور، فحري بنا اعتماد النصوص التاريخية التي خلفها أسلافنا في مدوناتهم للتثبت من أسماء تلك المباني.
ولعل أول ما ينبغي علينا تأكيده ، هو أن دار العامة غير قصر الجوسق الخاقاني، يقول اليعقوبي عن المعتصم بالله : (ثم ارتحل من القاطول إلى سر من رأى، فوقف في الموضع الذي فيه دار العامة، وهناك دير للنصارى، فاشترى من أهل الدير الأرض واختط فيه، وصار موضع القصر المعروف بالجوسق على دجلة، فبنى هناك عدة قصور) (1).
ويقول الطبري في حوادث سنة 223 ه_، عند عزم الخليفة المعتصم بالله على غزو عمورية: (فذكر أنه لما انتهى إليه الخبر بذلك صاح في قصره النفير ثم ركب .دابته.... فلم يستقم له أن يخرج إلا بعد التعبية، فجلس فيما ذكر في دار العامة، وقد أحضر من أهل مدينة السلام قاضيها عبد الرحمن بن إسحاق وشعيب بن سهل ومعهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون من أهل العدالة فأشهدهم على ما وقف من الضياع) (2).
وعقب مقتل المهتدي سنة 256 ه_ (أخرجوا أحمد بن المتوكل المعروف بابن فتيان وكان محبوساً في الجوسق فلما كان يوم الثلاثاء بايعوا أحمد بن المتوكل في القطائع وصاروا به يوم الأربعاء إلى الجوسق الهاشميون والخاصة فبايعه.. وركب أحمد بن
ص: 182
فتيان إلى دار العامة يوم الاثنين لثمان بقين من رجب فبايعوه بيعة العامة) (1).
وعرفت دار العامة باسم دار السلطان، يقول اليعقوبي: (كانت سر من رأى في متقدم الأيام صحراء من أرض الطيرهان لا عمارة بها، وكان بها دير للنصارى بالموضع الذي صارت فيه دار السلطان المعروفة بدار العامة، وصار الدير بيت المال) (2).
وعن بيت المال يقول الطبري في حوادث سنة 231ه_: (نقب قوم من اللصوص بيت المال الذي في دار العامة في جوف القصر وأخذوا اثنين وأربعين ألفاً من الدراهم وشيئاً من الدنانير يسيراً، فأخذوا بعد تتبع، أخذهم يزيد الحلواني صاحب الشرطة ) (3).
وعرفت أيضاً بدار الخلافة، ففي سنة 231 ه_ (عقد محمد بن الملك الزيات لإسحاق بن إبراهيم...، فيها على اليمامة وطريق مكة مما يلي البصرة في دار الخلافة، ولم يذكر أن أحداً عقد لأحد في دار الخلافة - إلا الخليفة - غير محمد بن عبد الملك الزيات) (4).
ويبدو أن الخليفة كان يجلس في دار العامة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع للنظر في الأمور العامة، فعندما جيء ببابك الخرمي أسيراً سنة 223ه_، أنزله الأفشين في قصره بالمطيرة، فلما كان من غد قعد له المعتصم يوم اثنين أو
الصورة
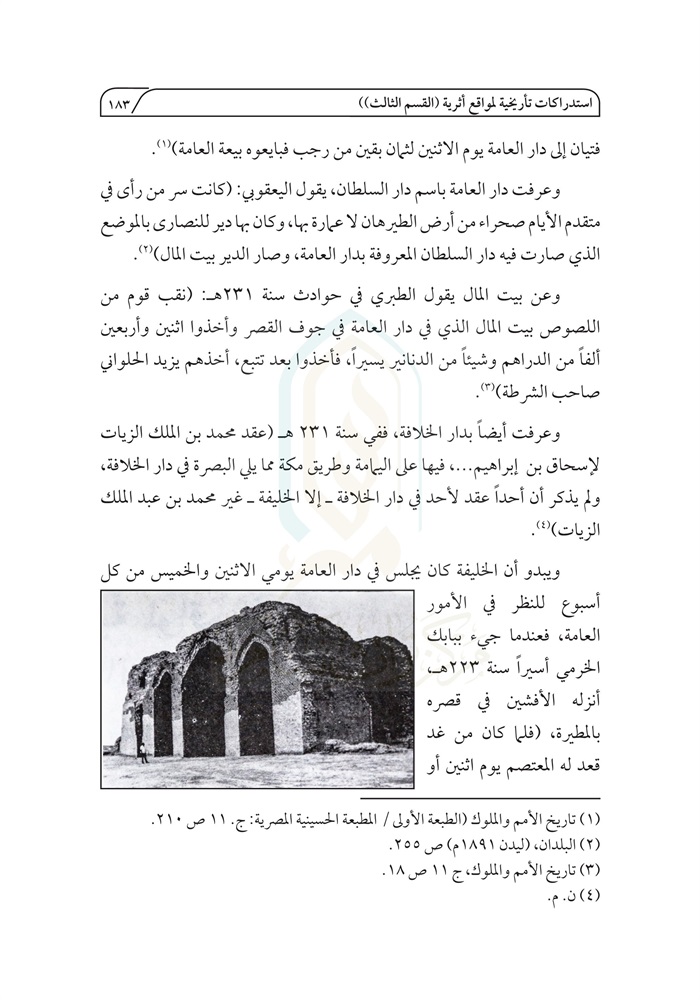
ص: 183
خميس، واصطف الناس من باب العامة إلى المطيرة، وأراد المعتصم أن يشهره ويريه الناس فقال : على أي شيء يحمل هذا ؟ وكيف يشهر ؟ فقال حزام: يا أمير المؤمنين لا شيء أشهر من الفيل. فقال: صدقت. فأمر بتهيئة الفيل وأمر به فجعل في قباء ديباج وقلنسوة سمور، وهو وحده.. فاستشرفه الناس من المطيرة إلى باب العامة، فأدخل دار العامة إلى أمير المؤمنين وأحضر جزار ليقطع يديه ورجليه، ثم أمر أن يحضر سياف فخرج الحاجب من باب العامة وهو ينادي نود نود، وهو اسم سياف بابك فارتفعت الصيَحَةُ بنود نود حتى حضر فدخل دار العامة ) (1).
وفي سنة 225 ه_ جيء بالمازيار إلى سامراء أسيراً ( فجلس المعتصم في دار العامة لخمس ليالٍ خلون من ذي القعدة وأمر فجمع بينه وبين الأفشين، وقد كان الأفشين حبس قبل ذلك بيوم (2)، وكان المعتصم قد أمر بالأفشين ( فحبس في الجوسق، ثم بنى له حبساً مرتفعاً وسماه لؤلؤة، وهو يعرف بالأفشين) (3)، وكان الحبس، كما يقول الطبري، (شبيها بالمنارة، وجعل في وسطها مقدار مجلسه، وكان الرجال ينوبون تحتها كما يدور) (4).
وعرفت دار العامة أيضاً بدار المعتصم، وفي بعض الأحيان يقتصر على تسميتها بالدار فقد ذكر عن هارون بن عيسى بن المنصور انه قال: (شهدت دار المعتصم وفيها أحمد بن أبي دواد وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب ومحمد بن عبد الملك الزيات، فأتي بالأفشين ولم يكن بعد في الحبس الشديد فأحضر قوم من الوجوه لتبكيت الأفشين بما هو عليه، ولم يترك في الدار أحد من أصحاب المراتب إلا ولد المنصور، وصرف الناس وكان المناظر له محمد بن عبد الملك الزيات) (5)، واختتم ابن أبي دؤاد المناظرة
ص: 184
قائلاً: (قد بان لكم أمره يابغا لبغا الكبير أبي موسى التركي) عليك به..، فقلب بغا ذيل القباء على رأسه ثم أخذ بمجامع القباء من عند عنقه ثم أخرجه من باب الوزيري إلى محبسه) (1).
وكان ابن أبي دواد قد (دعا) به في دار العامة من الحبس فقال له: قد بلغ أمير المؤمنين أنك يا حيدر أقلف، قال: نعم ، وإنما أراد ابن أبي دواد أن يشهد عليه، فإن تكشف نسب إلى الخرع، وإن لم يتكشف صح عليه أنه أقلف، فقال: نعم أنا أقلف وحضر الدار ذلك اليوم جميع القواد والناس، وكان ابن أبي دواد أخرجه إلى دار العامة قبل مصير الواثق إليه...) (2). وتوفي الأفشين في محبسه سنة 226 ه_، ف_ (أخرجوه فصلبوه على باب العامة ليراه الناس، ثم طرح بباب العامة مع خشبته، فأحرق وحمل الرماد وطرح في دجلة) (3).
ويبدو أن دار العامة كانت تجاور قصر الجوسق الخاقاني، وأن أحد أبوابها يسمى باب الوزيري، ربما كان نسبة إلى القصر الوزيري الذي استمد تسميته من اسم أبي الوزير أحمد بن أبي خالد، الذي كان كما يبدو يجاور دار العامة، بدليل إخراج الأفشين من دار العامة من باب الوزيري إلى محبسه) (4)الذي كان في قصر الجوسق الخاقاني. وفي رواية لليعقوبي يقول فيها: إن المعتصم (أحضر المهندسين فقال اختاروا أصلح هذه المواضع فاختاروا عدة مواضع للقصور، وصير إلى كل رجل من أصحابه بناء قصر، فصير إلى خاقان عرطوج أبي الفتح بناء الجوسق الخاقاني، وإلى عمر بن فرج بناء
ص: 185
القصر المعروف بالعمري، وإلى أبي الوزير بناء القصر المعروف بالوزيري) (1)، فيبدو أن قصور المعتصم هذه كانت متقاربة، وعلى مقربة منها يقع القصر الهاروني، الذي لا زالت بعض أطلاله ترى على دجلة في الموقع المعروف بالكوير، بعد وفاة المنتصر سنة 248 ه_(اجتمع الموالي إلى الهاروني يوم الأحد ) (2)واختاروا أحمد بن محمد بن المعتصم للخلافة (فبايعوه وقت العشاء الآخرة من ليلة الاثنين) (3).
ويضيف الطبري قائلاً عن المستعين: (فلما كان يوم الاثنين لست خلون من شهر ربیع الآخر صار إلى دار العامة من طريق العمري بين البساتين وقد ألبسوه الطويلة وزي الخلافة، وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة قبل طلوع الشمس، ووافى واجن الأشر وسني باب العامة من طريق الشارع على بيت المال فصف أصحابه صفين وقام في الصف هو وعدة من وجوه أصحابه، وحضر الدار أصحاب المراتب من ولد المتوكل والعباسيين والطالبيين وغيرهم ممن لهم ،مرتبة، فبيناهم كذلك وقد مضى من النهار ساعة ونصف جاءت صيحة من الشارع والسوق) (4)، وبعد إتمام البيعة (انصرف الأتراك وقد بايعوا أحمد بن محمد بن المعتصم، وانصرفوا مما يلي العمري والبساتين، وأخذ الموالي قبل انصرافهم البيعة على من حضر الدار من الهاشميين وغيرهم وأصحاب المراتب، وخرج المستعين من باب العامة منصرفاً إلى الهاروني فبات هنالك ) (5).
وبناءً على ما تقدم، فإنه يبدو لي أن لدار العامة عدة مداخل، من خلالها تتصل بقصور الخليفة: الجوسق، والعمري، والوزيري. أما مدخلها الشهير بباب العامة، فهو المدخل الذي تتصل فيه الرعية بالسلطة، فيفترض به أن يكون اتجاهه نحو المدينة وبيوت ساكنيها، وهذا ما يمكن استخلاصه من قول الطبري سابق الذكر: (...
ص: 186
جاءت صيحة من ناحية الشارع و السوق) (1)، فقد كان أصحاب المستعين عند باب العامة عند قدوم أنصار المعتز ، فكان القتال عنده، والمعروف ان الأسوق كانت تقوم عند مسجد سامراء الجامع.
أما قصر الجوسق الخاقاني فإنه كان قريباً من الجسر الذي عقده المعتصم على دجلة لربط جانبي سامراء الشرقي بالغربي، وبينهما البستان الخاقاني، يستشف ذلك من خلال حادثة بغا الشرابي سنة 254ه_ ، يقول الطبري: إن بغا عندما (جن عليه الليل دعا بزورق فركبه مع خادمين معه... ولا يعلم أهل عسكره بذلك من أمره... فصار بغا إلى الجسر في الثلث الأول من الليل، فلما قارب الزورق الجسر بعث الموكلون به من ينظر في الزورق ، فصاح بالغلام فرجع إليهم، وخرج بغا في البستان الخاقاني، فلحقه عدة منهم فوقف لهم وقال: أنا بغا. ولحقه وليد المغربي...، فوکل به وليد المغربي ومرّ يركض إلى الجوسق، فاستأذن على المعتز فأذن له فقال: يا سيدي، هذا بغا قد أخذته ووكلت به قال: ويلك جئني برأسه. فرجع وليد فقال للموكلين به: تنحوا عنه (فقتله وحمل رأسه) وأتى به المعتز) (2).
وما يسمى بباب العامة يبدو لي أنه مدخل قصر الجوسق الخاقاني من ناحية النهر ، الذي كان يخرج منه المعتصم للنزهة في دجلة، وربما كان هو المقصود فيما روي عن زنام الزامر قوله : (قد وجد المعتصم في علته التي توفي فيها إفاقة، فقال: هيئوالي الزلال لأركب غداً، قال فركب وركبت معه، فمر في دجلة بإزاء منازله(3))، وكان خروج المعتصم في نزهته هذه من قصر الجوسق ، وبعد عودته إليه توفي ودفن فيه سنة 227 ه_(4) .
ص: 187
وفي قصر المتوكل على الله (الجعفري) الذي قتل فيه سنة 247 ه_، مدخل مطل على النهر ، يسمى (باب الشط) ربما كان شبيهاً بما يسمى بباب العامة، ورد ذكره في حادثة مقتل المتوكل، حيث إن (بغا الشرابي أغلق الأبواب كلها غير باب الشط، ومنه دخل القوم الذين عينوا لقتله (اي لقتل المتوكل ) (1)، وكان عبيد الله بن يحيى في أحد أقسام القصر، وعندما أبلغ بمقتل المتوكل (خرج فيمن معه من خدمه وخاصته فأخبر أن الأبواب مغلقة، فاخذ نحو الشط فاذا أبوابه أيضاً مغلقة، فأمر بكسر ما كان مما يلي الشط، فكسرت ثلاثة أبواب حتى خرج إلى الشط فصار إلى زورق فقعد فيه) (2).
وباب العامة الذي استمد تسميته من عامة الناس، يفترض أن يكون اتجاهه نحو المدينة وبيوتات ساكنيها ، وهو نقطة اتصال الرعية بالسلطة عندما تستجد الحاجة إلى ذلك، وعنده تنفذ الدولة العقوبات الصادرة بحق الخارجين عليها وعلى قوانينها من جلد إلى صلب، وفيه تعلّق رؤوس من ينفذ فيهم حكم الإعدام (3) لكي يرتدع من تسوّل له نفسه الخروج على الدولة، ومحاولة الإخلال بأمنها، وعنده يتجمهر جمهور الناس ليرى ذلك، ويشاهد ما تريد الدولة أن تريه إياه (4)، أو سماع البلاغات التي ترغب السلطة إبلاغه إياها . فهل أن موقع ما يسمى بباب العامة في سامراء يناسب مثل هذه الأغراض ؟ اعتقد أنّ الجواب سيكون بالنفي، ذلك إن اتجاهه نحو النهر، ولیس امامه متسع من متسع من مكان لتجمهر الناس، وما يقابله مشغول بالسهل، والبركة المتصلة بدجلة، والحدائق والبساتين.
أما دار العامة التي يؤلف باب العامة واحداً من أبرز أجزائها، فهي دار الحكم،
ص: 188
ومقر وزير الخليفة، وقاضي قضاة الدولة، والكتاب وغيرهم، فيها تصرف شؤون الدولة السياسية والدينية والإدارية والمالية وفيها تعقد المناظرات والمحاكمات(1)، والنظر في المظالم (2)، وبيعة الخلفاء العامة تؤخذ فيها(3)، ومنها تصدر أوامر تعيين الولاة على الأقاليم(4) ، والخليفة يجلس فيها يومين من كل أسبوع(5) للاطلاع على مجريات الأمور وتقرير ما ليس من اختصاص غيره.
وبعبارة اخرى فإن دار العامة تمثل الجانب الظاهر والمكشوف من حياة الخليفة اليومية أمام عامة الناس، فهل يعقل تضمن مثل هذه الدار ما له علاقة بخصوصيات الخليفة. أو بمعنى اخر الجانب الخاص من الحياة اليومية للخليفة، وهو الذي لا تطلع عليه الرعية. ولا ينبغي ان يصل إلى أسماعها شيء منه. وهل يعقل احتواء مثل هذه
ص: 189
الدار على القسم الخاص بنساء الخليفة وجواريه، أو ما يسمى بقسم الحريم، الذي كشفت عنه حفريات هرتسفلد، لا بل عثر أيضاً على رسوم نساء شبه عاريات (1) فهل المنطق يقر تزيين دار العامة بالصور الآدمية التي وقف منها الإسلام، متمثلاً بفتاوي وآراء علمائه، موقفاً عدائياً، فضلاً عن أن تكون صور نساء، وعاريات أيضاً! فكيف يمكننا تحليل ظاهرة وجودها في مكان يرتاده علماء وفقهاء في الدين وغيرهم، إن المنطق والمعقول لا يقرّ مثل ذلك، بل يقر وجود مثل هذه الأشياء في قصور الخليفة الخاصة التي لا يصلها الا أولئك المقربون من الخلفاء، الذين أمن الخلفاء جانبهم من هذه الناحية، فلا يجدون حرجاً أو يخشون بأساً منهم، وقصر الجوسق الخاقاني أحد هذه القصور الخاصة.
الصورة
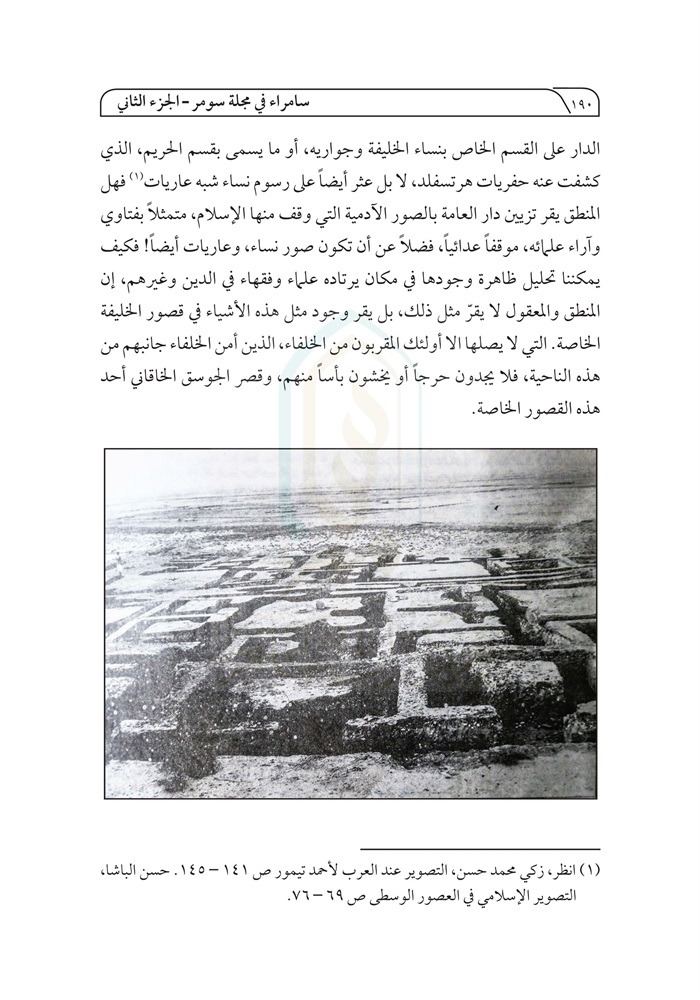
ص: 190
من كل ما تقدم أخلص إلى النتائج التالية:
1 - ان قصر الجوسق الخاقاني هو غير دار العامة.
2- ان ما يسمى بباب العامة ليس باب العامة، وإنما هو أحد مداخل قصر الجوسق الخاقاني، وإن البقايا البنائية إن هي الا بقايا هذا القصر.
3- إن قصور المعتصم الجوسق والعمري، والوزيري، كانت متقاربة تطل على دجلة، تفصل بعضها عن بعض الحدائق والبساتين، وهي قريبة من الهاروني والجسر، ولها مداخل شارعة نحو دار العامة.
(2) أضواء على قصر الجص
من مباني الخليفة المعتصم بالله التي شادها في جانب سامراء الغربي (قصر الجص)، الذي يقول عنه ياقوت الحموي : (قصر عظيم قرب سامراء فوق الهاروني بناه المعتصم للنزهة) (1). وينصّ ابن حزم الاندلسي على انه مقر سكنى أحمد بن الخليفة المعتصم، حيث يقول عنه: (كان جليلاً في نفسه مقدماً في قومه، وكان يعقوب بن إسحاق الكندي أخص الناس به، هو الذي مدحه حبيب... سكناه بقصر الجص) (2). وقد استدلت مديرية الآثار القديمة على أن قصر الجص هو القصر المكتشف بموقع الحويصلات (3)، من خلال نصّ واحد، هو نص لسهراب حول نهر الإسحاقي
ص: 191
حيث يقول : (يحمل من دجلة من غربيها، نهر يقال له الإسحاقي أوله أسفل تكريت بشيء يسير يمر في غربي دجلة عليه ضياع وعمارات، ويمر بطيرهان ويجيء إلى قصر المعتصم بالله المعروف بقصر الجص ) (1). ورغم ان نصّ سهراب الذي اعتمدته مديرية الاثار القديمة في استدلالها سابق الذكر، والذي اعتمده كل من تعرض للقصر من الباحثين دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن نصوص أخرى جديدة تعزز مثل هذا الرأي غير كاف خصوصاً وان نصّ ياقوت الحموي غامض، يثير اللبس. ويدعو إلى التساؤل، حيث يفهم منه وقوع قصر الجص في جانب دجلة الشرقي؛ لوقوعه فوق الهاروني قصر الخليفة هارون الواثق، الذي لا مجال للشك في أنه يقع في سامراء الشرقية، ومع ذلك، فإنها، أعني مديرية الاثار القديمة، قد أصابت كبد الحقيقة كما أرى، يقول عز الدين بن الأثير الجزري في حوادث سنة ه_: وفيها (سار مؤنس المظفر إلى الموصل مغاضباً للمقتدر ) (2) ، غير انه لم يتجه مباشرة اليها، حيث يقول عريب القرطبي : (فسار مؤنس إلى سر من رأى وعسكر بالجانب الشرقي، واجتمع الناس بقصر الجص، فكلّمهم ووعدهم) (3). ويضيف قائلًا: (وأقام يومه ذلك بقصر الجص ، فاحترق سقف من سقوف القصر ، فشقّ ذلك على مؤنس واجتهد في إطفاء النار فتعذر ذلك عليه، ثم سار وهو مغموم، لما دار من الحريق في القصر، يريد الموصل) (4).
ومما هو جدير بالذكر ان أبا عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني المعروف ،بالبتاني، الذي يقول فيه ابن العبري: (أحد المشهورين برصد الكواكب، ولا يعلم أحد من الإسلام بلغ مبلغه في تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها) (5) كان
ص: 192
قد (ورد بغداد مع بني الزيات من أهل الرقة في ظلامات كانت لهم، فلما رجع مات في طريقه بقصر الجص سنة سبع عشرة وثلثمائة) (1).
وفي سنة 332 ه_، وقع الخلاف بين الخليفة المتقي الله وأمير الأمراء توزون التركي، فالتجأ الخليفة إلى بني حمدان، (وأصعد الخليفة إلى الموصل، وأقام ناصر الدولة بتكريت، وسار توزون نحو تكريت فالتقى هو وسيف الدولة ابن حمدان تحت تكريت بفرسخين، فاقتتلوا ثلاثة أيام ثم انهزم سيف الدولة) (2). بينما يقول الهمداني: (وسار توزون اليهم إلى قصر الجص ) (3). ويؤكد ذلك مسكويه قائلا: ( وانحدر ناصر الدولة ومعه الجيش، ووصل إلى تكريت فتلقاه الخليفة، وسار توزون إلى عكبرا وعبر من الجانب الشرقي إلى قصر الجص بسرّ من رأى) (4) .
وفي سنة 367 ه_، يقول مسكويه، كانت (الوقعة بين بختيار ومن جمع وبين عضد الدولة بقصر الجص) (5) ، وكان قد (اتصل بعضد الدولة ان القوم أجمعوا على أن يتفرقوا بعد عبور النهر المعروف بالإسحاقي، ويأخذوا في عدة وجوه إلى بغداد، فسار بجميع عساكره إلى قصر الجص ) (6).
ويقول ابن الأثير: (وسار بختيار إلى المدينة واجتمع مع أبي تغلب وسارا جميعاً نحو العراق، وكان مع أبي تغلب نحو من عشرين ألف مقاتل، وبلغ ذلك عضد
ص: 193
الدولة، فسار عن بغداد نحوهما، فالتقوا بقصر الجص بنواحي تكريت) (1).
ويقول يحيى بن سعيد الانطاكي: (فنهض عضد الدولة اليهما ونهض الطائع معه، والتقى الفريقان بقصر الجص) (2).
ويقول أبو الفدا: (فخرج عضد الدولة من بغداد نحوهما، والتقوا بقصر الجص من نواحي تكريت) (3).
ويؤكد ذلك أبن الوردي قائلاً: ( والتقوا بقصر الجصّ من نواحي تكريت) (4) .
ويقول مسكويه: (فأما عضد الدولة، فانه لما فرغ من وقعة قصر الجص تم المسير إلى الموصل فملكها) (5) .
وفي موضع آخر يضيف: (وبرز الطائع الله يوم الخميس لخمس خلون منه [من شوال سنة 367 ه_ ] فلما انهزم بختيار وابو تغلب من الوقعة بحضرة قصر الجص عاد الطائع لله إلى منزله ببغداد، وسار عضد الدولة كما ذكرنا فيما قبل إلى الموصل) (6).
ووللصابي رسالة عن هذه الموقعة، يقول عنها: (وكتب عن نفسه إلى الملك عضد الدولة وتاج الملة جواباً عن كتابه بقتل بختيار بن معز الدولة، وانهزام أبي تغلب بن حمدان، والظفر بجماعة من القواد بالجانب الغربي بقصر الجص المحاذي لسرّ من رأى، وذلك في سنة سبع وستين وثلثمائة ) (7).
ص: 194
من كل ما تقدم نخلص إلى أن قصر الجص يقع في الجانب الغربي من سامراء على نهر الإسحاقي، على مقربة من تكريت، بحيث يعد من نواحيها، وهو يطابق موقع القصر المكتشف بالحويصلات.
(3) مسجد سامراء الجامع
ليس هناك ثمة شك في أن مسجد سامراء الجامع من أبنية الخليفة المتوكل على الله، ثالث خلفاء سامراء العباسيين، رغم أن بعضاً من المؤرخين كابن الكازروني(1)، وابن قنيتو الاربلي (2) - نسبوه إلى الخليفة المعتصم بالله يقول اليعقوبي : (الجامع القديم الذي لم يزل يجمع فيه إلى أيام المتوكل، فضاق على الناس فهدمه، وبنى مسجداً جامعاً واسعاً في طرف الحير ) (3)، واذا ما علمنا بأن المتوكل على الله كان مولعاً بنقض المباني، حتی تلك التي شادها هو بنفسه، واستخدام موادها بمبانٍ أخرى جديدة (4) ، جاز لنا أن نصدق رواية اليعقوبي هذه ، التي يفهم منها ان المتوكل شاد مسجده هذا على أنقاض مسجد المعتصم الجامع وفي نفس البقعة غير ان البلاذري يروي رواية أخرى مغايرة لتلك التي رواها اليعقوبي، يفهم منها ان المتوكل قد شيد مسجده هذا في غير الموضع الذي كان يقوم فيه مسجد المعتصم الجامع ، يقول البلاذري: ان المتوكل (بنى مسجداً جامعاً كبيراً، واعظم النفقة عليه ، وأمر برفع منارته لتعلو اصوات المؤذنين
ص: 195
فيها، حتى ينظر إليها من فراسخ، فجمع الناس فيه وتركوا المسجد الأول) (1).
ولكن متى ابتدأ المتوكل على الله ببناء هذا المسجد، وفي أية سنة كان الفراغ منه ؟ يقول الدكتور أحمد فكري : (المعروف أن الخليفة المتوكل هو الذي بنى المسجد الجامع في سامراء، ولكنه لا يعرف تحديداً تاريخ بنائه له. وقد تولى المتوكل الخلافة فيما بين سنتي 232 - 247 ه- / 847- 861م، فيكون المسجد قد شيد فيما بين هاتين السنتين) (2) ، والحقيقة ان ما قاله الدكتور فكري لا يتسم بالدقة، إذ تتوفر لدينا نصوص تاريخية تحدد لنا تاريخ البدء بالبناء، وتاريخ الانتهاء منه ، فالبدء به كان سنة 235ه_(3) ، لا سنة 234 ه_(4) كما ذهب كل من حاول تاريخ مسجد سامراء الجامع من الباحثين، وتكامل البناء في سنة 237 ه_(5).
ص: 196
الصورة
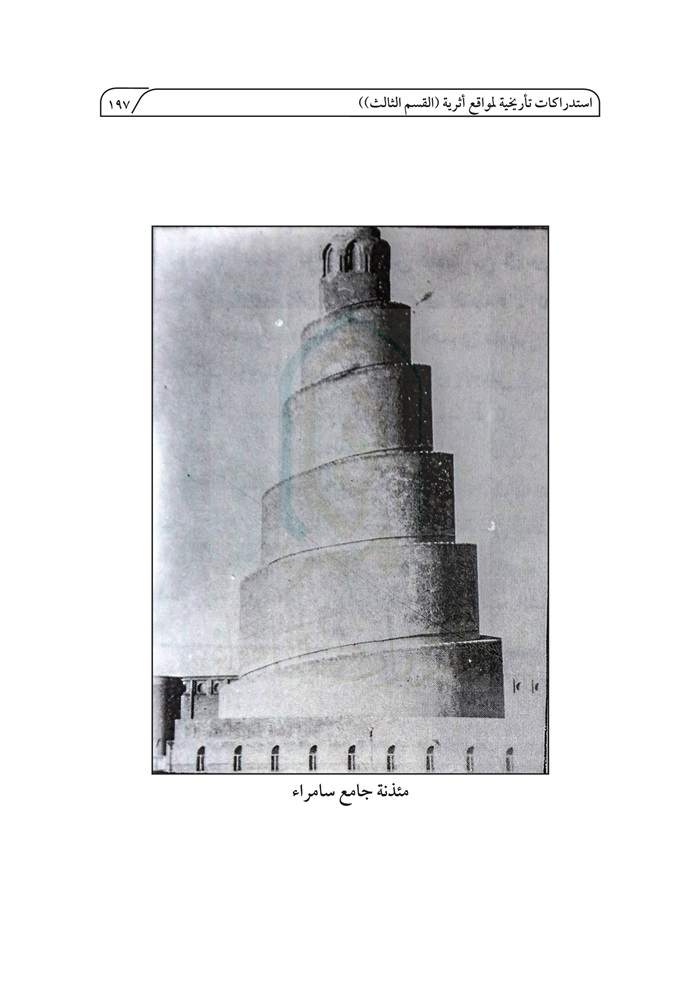
ص: 197
ص: 198
المجلد التاسع والثلاثون سنة 1983م.
زينب صادق السمكري
منقب آثار
تمهید
أضع بين يدي القارئ الكريم صفحات متواضعة من ببلوغرافيا سامراء، والذي دفعني إلى اختيار سامراء بالذات لإجراء هذا العمل هو :
1 - إن سامراء من المدن الإسلامية التي ما تزال آثارها شاخصة للعيان، من مآذن وقصور ومساجد واسواق بشكل يلفت النظر ، مما يدل على أهمية ومكانة هذه المدينة العباسية تاريخيا.
2 - ان الفترة التي عاشتها سامراء عاصمة الخلافة العباسية، وهي مدة تقل عن خمسين سنة، فترة مهمة وحاسمة، وهذا ما أضفى عليها أهمية استثنائية، ولا سيما من حيث طرز البناء.
3- اهتمام القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس المناضل المهيب الركن صدام حسين(1)، نتيجة تقديره لأهمية سامراء التاريخية والأثرية، من حيث انها جزء هام من الحضارة والتراث العربيين في هذا الوطن، وأود أن أوضح بأنه سبق للسيد
ص: 199
سلمان وفيق أن قام بجمع بعض المراجع الأجنبية عن سامراء، وقد طبعت بالرونيو عام 1980، وقد فاته كثير من المراجع التي قمت باستقصائها لاستكمال الموضوع. وختاماً أرجو أن أكون قد وفقت لتحقيق ما كنت أقصده، والله من وراء القصد.
ببلوغرافيا عن سامراء
- آل فرعون «فريق مزهر» -
*الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة 1920. بغداد، النجاح 1952 ج 1 ص 330. 328.79.
- الآلوسي «سالم»: -
*موجز آثار سامراء – مديرية الآثار العامة بغداد - دار الجمهورية 1965م.
*ميادين السباق في سامراء الأقلام - مجلة السنة الأولى، العدد 3 / 1964، ص 103.
- ابن بطوطة «محمد بن عبد الله » 1304 - 1377 ه_
*رحلة ابن بطوطة أو تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، القاهرة، المطبعة الخيرية، 1904 ، ص 138، 147 .
- ابن جبير «محمد بن احمد» 1145 - 1217ه_
*رحلة ابن جبير - ليدن ،بریل، 1852 ص 232 .
- ابن خلكان «أبو بكر أحمد بن محمد» 1211 - 1282 ه_
*وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان القاهرة، مكتبة النهضة المصرية 1948 ج 1 ص 373 - ج 2 ص 435 .
- ابن الساعي «علي بن أنجب» 1197 – 1275 ه_
ص: 200
* الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير. بغداد، المطبعة السريانية الكاثوليكية، 1934 ص 76. عني بنشره ووضع فهارسه د. مصطفى جواد.
- ابن سلیمان «مار»
*أخبار فطاركة كرسي المشرق - روما 1899، ص77.
- ابن الضحاك «الحسين» قال في وصف سامراء.
* معجم البلدان - سامراء - وستلفد - طبعة لايبزك، 1866 ج 3 / أص. 19.
- ابن فضل الله العمري «أحمد بن يحيى» 1301 - 1349 ه_.
* مسالك الأبصار ج 1 ، القاهرة، دار الكتاب المصرية، 1924، ص 283، 263.
- ابن الفوطي «عبد الرزاق بن احمد» 1244 - 1323 ه_.
*الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة - بغداد، المكتبة العربية، 1932 ، ص 152 - 154 ، ص 203-204.
- ابن المعتز «عبد الله» قال في سامراء
*طبقات الشعراء، مصر، دار المعارف، 1956 ، ص 423 ، الجزء الرابع من شعر عبد الله بن المعتز، صنعه أبي بكر الصولي، عني بتصحيحه ب. لوين استانبول، مطبعة المعارف 1945، ج 4 ص 91 - ص 95 ، ص 62 .
-أبو تمام «الطائي»
*ديوان أبي تمام شرح شاهين عطية، بيروت، المطبعة الاوربية 1889 ، ص 235 .
- أبو داود «احمد» قال في سامراء
ص: 201
*اخبار القضاة - لوكيع – القاهرة، 1950، ص 3.
وفي معجم البلدان تنسب القصيدة إلى الحسين بن الضحاك، ص299.
- أبو الفدا «عماد الدين إسماعيل» 732 ه_
*تقویم البلدان، سر من رای، باریس ص 300-301، المطبعة الاوربية 1889 ، ص 235 .
- الأصيل «ناجي»
*مدينة المعتصم على القاطول استكشاف سومر، مجلة، م3. 1947، ص 160 - 170 .
- الأعظمي «خالد خليل»
*خزف سامراء وصيانته - سومر ، مجلة 30، 1974، ص 203-222 .
*قصر الخليفة المعتصم في سامراء /سومر، مجلة ، م 38 لسنة 1982 ص 168 .
- أمين «حسين»
*سامراء في ظل الخلافة العباسية . بيروت، دار الكتب، 1968.
- الامين «عبد الوهاب»
* بلدة القاطول، مترجم، سومر، مجلة ، م 4 ، 1948، ص 145
- بابان «جمال»
* أصول أسماء المدن والمواقع العراقية ج 1 ، المجمع العلمي الكردي، بغداد، 1976 ، ص 198 - 200.
- البحتري «وليد بن عبيد» 821-898 ه_
* ديوان البحتري، تحقيق: حسن كامل الصير في مصر، دار المعارف 1963 -
ص: 202
1964 ج 1 ص 9 ، ص 340 - ص 431 ، ج 2 ص 955 ص 1249 ص 1100.
- البلاذري «احمد بن يحيى» 892 ه_
*فتوح البلدان، طبعة ليدن - بريل 1866 ص 297-298 .
- الجهشياري «محمد بن عبدوش» 331 ه_
*الوزراء والكتاب مصر. مطبعة البابي ص 177.
- الجواهري «محمد مهدي»
* ديوان الجواهري. النجف، مطبعة الغري 1935 ص 11-16 .
- الحسني «عبد الرزاق»
* سامراء في التاريخ - الدليل (مجلة) - العدد 1-2 السنة الثانية 1947م، ص7.
*العراق قديما وحديثا صيدا - العرفان 1958م ، الطبعة الثالثة، ص 109 – 115.
- الحصري «ساطع»
*«حول تأسيس مدينة سامراء» - الثقافة (مجلة) - م 2 1940 العدد 59 ص 62-63 .
-الحلي «السيد حيدر»
* ديوان السيد حيدر الحلي - طبعة الهند، ص 178 – 41 – 42.
- الخليلي «جعفر»
*موسوعة العتبات المقدسة - قسم سامراء - ج 1 - بغداد. دار التعارف.
- الدجيلي «كاظم»
ص: 203
*نظرة عامة في سامراء، لغة العرب (مجلة) ، م 19111، ص 83-94 .
- دوند لس
*سامراء مدينة أواخر الأئمة عقيدة الشيعة - ترجمة عبد المطلب الامين - القاهرة 1946 ص 244-251 .
- الراوي «صادق عبد الحميد»
*دراسة حول صيانة الأسوار والمباني في سامراء / سومر م38 لسنة 1982، ص 206.
-رجب «يوسف»
*ساعة بين الأطلال في سامراء. الاعتدال (مجلة)، م3 1936، ص 429 – 434.
- الزين «احمد عارف»
*سامراء، العرفان (مجلة)، العدد 24 ، 1933 - 1934.
- السامرائي «عامر رشيد»
*سامراء بين القديم والحديث أهل النفط (مجلة)، العدد 59 ، السنة الخامسة 1956، ص 30-31.
- السامرائي «عبد الجبار محمود»
* (جامع الملوية في سامراء)، التراث الشعبي (مجلة)، العدد 6 ، السنة السادسة 1975 ، ص 272.
- السامرائي «يونس إبراهيم»
*الأزياء الشعبية في سامراء، بغداد، دار البصري 1969.
ص: 204
*(أسرار مراقد سامراء)، صوت الإسلام (مجلة)، العدد 25-40 1967، ص27.
*الألعاب الشعبية لصبيان سامراء، بغداد، دار الجمهورية 1965.
*الإمام محمد الدور - بغداد 1964 .
*تاريخ الدور قديما وحديثا، بغداد، دار البصري 1966.
* تاريخ شعراء سامراء من تأسيسها حتى اليوم. بغداد، دار البصري 1970.
* تاریخ عشائر سامراء ، بغداد. دار البصري 1961.
*تاریخ علماء سامراء، بغداد، دار البصري 1966.
*تاريخ مدينة سامراء، بغداد، مختلف الطبعات بغداد 1968 - 1973.
*تراث سامراء ، بغداد، الامة 1974.
* دلیل سامراء، بغداد - دار البصري 1962 .
*الديارات في سامراء، صوت الإسلام (مجلة)، العدد (12) 1964، ص 15.
*الزخارف الجصية في سامراء، صوت الإسلام (مجلة)، العدد 35، 36 السنة الأولى 1965 ص 3 ص 8 .
*سامراء بعد الفتح العربي، صوت الإسلام (مجلة)، العدد 7، السنة الأولى 1964 ص9 .
*سامراء عاصمة العباسيين، صوت الإسلام (مجلة) العدد 11 السنة الأولى 1964 ، ص 10 .
* سامراء في الرحلات العربية، العاملون في النفط (مجلة)، العدد 93 السنة التاسعة 1970 ، ص 12 .
ص: 205
*العادات والتقاليد العامية في سامراء، بغداد، دار البصري 1969 .
*عبارات السلوك العامية في سامراء، بغداد، دار البصري 1969.
* العمارة في الحضرة العسكرية سامراء، بغداد (مجلة)، العدد 1965 ص 6.
*الكتابة العامية في سامراء بغداد، دار البصري 1968.
* مساجد سامراء العامرة، بغداد (مجلة)، العدد الثاني 1965 ، ص 28
*المدرسة العلمية في سامراء، بغداد (مجلة)، العدد 26 ، 1966 ، ص 13 .
* مراقد الأئمة والأولياء في سامراء - منشورات صوت الإسلام، 1966، بغداد.
- السامرائي «يونس أحمد»
*سامراء في أدب القرن الثالث الهجري - بغداد ، مطبعة الارشاد، 1968.
*البحتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل بغداد - الارشاد 1970.
* البحتري في سامراء بعد عصر المتوكل بغداد - الارشاد 1971
- السماوي «محمد»
*أرجوزة في تاريخ سامراء . النجف، مطبعة الغري 1941.
*وشايح السراء في شأن سامراء. النجف الغري 1360 ه_ ص 5 ، 7، 28، 45.
- سوسة (أحمد)
* البركة الجعفرية في سامراء، بغداد (مجلة)، العدد الأول 1963 ص 12 .
* حير المتوكل للوحوش في سامراء، العراق الجديد (مجلة)، العدد 10 / 1962 ، ص 9 .
ص: 206
*الدليل الجغرافي العراقي / بغداد، مديرية المساحة ص 54.
*ري سامراء في العصر العباسي ج 1 - ج 2 1948 – 1949
*سامراء ومشروع نهر الإسحاقي العراق الجديد (مجلة)، العدد السادس 1962 ، ص 23 .
*قناة المتوكل الدليل (مجلة)، العدد 4 ، السنة الثانية 1947، ص 167، العدد 5 ، السنة الثانية 1948 ، ص 229 ، العدد 6 ، السنة الثانية 1948 ، ص 265 .
- الشابشتي «علي بن محمد» 998 ه_
*الديارات بغداد المعارف الطبعة الثانية ، مكتبة المثنى، تحقيق كوركيس عواد . 1966 ص 163 - 165 .
- شريف «يوسف»
* قصر الخليفة أو دار العامة في سامراء، آفاق عربية (مجلة)، العدد 10 / 1977 ، ص 28.
- شيخو «لويس»
*سامراء، المشرق (مجلة) ، م 16 / 1913 ، ص 64 - 66 .
- صالح «الدكتور قحطان رشيد»
* قصور عباسية في تراثنا الشعري مجلة سومر - م / 38، ص 162 .
- الطنطاوي «علي»
*ساعة في سر من رأى الرسالة (مجلة)، العدد الخامس/ 1937، ص 662 - 666 .
- العاملي «محسن الامين الحسيني»
ص: 207
*أعيان الشيعة، ج 1، القسم الثاني / بيروت، الطبعة الثالثة، الإنصاف 1951 / 1960 ، ص 397 .
- العاني «علاء الدين أحمد نجم»
*استدراكات اثارية ق 2 / سومر ، م ،38 ، لسنة 1982 ، ص 256 .
*استدراكات اثارية ق 3 / سومر ، م 39، لسنة 1983، ص 261 .
- عبد الباقي «أحمد»
*«سامراء»، الندوة (مجلة)، العدد الأول، 1965 ، ص 29 .
- عزام «عبد الوهاب»
*رحلات عبد الوهاب عزام القاهرة - الرسالة .1939 .
- العزاوي «عباس»
* تاريخ العراق بين احتلالين. بغداد 1935 - 1956 ج 4 ص 72، ج 5 ص 166 - 199 ، ج 6 ص 115 ، ج 7 ص 109 - 169، 244، ج 8 ص 43 ، ص 305 – 307.
- علي «محمود» والعينه جي ده والعينه جى «المحمود»
*جامع أبي دلف في سامراء. سومر (مجلة) م 3/ 1947، ص 60 - 76 .
- العمر «إبراهيم حلمي»
العشائر القاطنة بين بغداد وسامراء. لغة العرب (مجلة)، العدد الثاني، 1912، ص 82-، 88 ص 124-132.
- العميد «طاهر مظفر»
*عمارة سامراء العباسية في عهد المتوكل، سومر (مجلة) م 32 / 1976 ، ص
ص: 208
235 – 191.
* العمارة العباسية في سامراء في عهدي المعتصم والمتوكل، بغداد (مجلة) وزارة الاعلام، 1976.
- عواد «كوركيس»
*سامراء. سومر (مجلة) م 1952/8 ، ص 263 .
- الغزولي «علاء الدين علي بن عبد الله»
* مطالع البدور في منازل السرور القاهرة مطبعة الوطن، جزئين في مجلد واحد - 1299 ه_.
- فرنسيس بشير وعواد «كوركيس»
*المنارة الملوية العراق في القرن السابع عشر (مترجم) من الرحلة التافرنية، ص 148 - 149 .
- فرنسيس «بشير» العينه جي «محمود»
*جامع أبي دلف في سامراء، سومر (مجلة)، العدد 3، 1947 ، ص 60 - 67 .
- الفكيكي «توفيق»
*سامراء وأطلالها، اليقين / مجلة م 3 / 1343 ه-، ص 265 - 271، ص 326 - 329 ص 374 - 377، ص 394 - 406 .
- فيوليه
*دائرة المعارف الإسلامية تعريب أحمد الشنتناوي، وإبراهيم زكي خورشید، وعبد الحميد يونس مصر ، الاعتماد، 1933 ، م 11، ص 1 ، ص 82 - 87.
- القرغولي «جهادية»
ص: 209
* الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في سامراء في القرن الثالث الهجري، بغداد - دار البصري، 1969 .
- القرماني «احمد بن يوسف» 1532 - 1610
*أخبار الدول وآثار الأول المعروف بتاريخ القرماني، بغداد 1282 ه_ ، ص 454.
- القزويني «زكريا بن محمد» 1208 - 1283 ه_
*آثار البلاد واخبار ،العباد ،بیروت، دار صادر، 1960 ، ص 258 .
- القيسي «ربيع»
*جامع الملوية في سامراء - تخطيط وصيانة ، م 25 سومر (مجلة) 1969، ص 143 – 162.
* الصيانة الأثرية في قصر العاشق في سامراء، سومر (مجلة) م 23 / 1967، ص188 - 183 .
* الملوية منارة المسجد الجامع في سامراء، سومر (مجلة) م 26 / 1970 ، ص 277 - 284 .
- الكركوكلي «رسول»
*دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء، نقله عن التركية موسی کاظم نورس - بيروت، مطبعة كرم، ص 199.
- الكرملي «انستاس» 1866 - 1947
*آثار سامراء الخالية وسامراء الحالية، لغة العرب (مجلة) ، م 1 / 1911 ، ص 82 - 81 .
ص: 210
- كوتزه «البرخت»
*بلدة القاطول سومر (مجلة) م 4 / 1948 ، ص 145 ، ص 103 - 112 .
- كروزون
*تأسيس مدينة سر من رأى، ترجمة محمد رجب، المقتطف، (مجلة) م 95 / 1939 ، ص 46 - 52 ، ص 181 - 190 ، ص 454 - 461، ص 567 - 576 .
- لسترنج
*بلدانية الخلافة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، بغداد / الرابطة 1954 ، ص 76 - 77.
- المحلاتي «ذبیح الله»
* مآثر الكبراء في تاريخ سامراء ج 1 - ج 3، النجف : مطبعة الحيدرية 1931.
- محمد حسن «زكي»
الفن الطولوني وسامراء الفن الإسلامي في مصر القاهرة 1935 ص21 - 34 .
- مديرية الآثار العامة
*الآثار القديمة في العراق (سامراء) ، بغداد - مطبعة الحكومة 1940.
حفريات سامراء بغداد 1936 - 1939 ج 1 - ج 2 .
* دليل تاريخي على مواطن الآثار في العراق. بغداد - الرابطة 1953 ص 41 - 42 .
-المسعودي «ابو الحسن علي بن الحسين»
*التنبيه والاشراف، مراجعة وتصحيح إسماعيل الصاوي مصر مكتبة الشرق
ص: 211
الإسلامية 1938 ص 306.
* العيون والحدائق ،بريل ليدن 1869 ص 381.
*مروج الذهب ومعادن الجوهرج 2، مصر، المطبعة البهية 1346ه_ ص 349 - 350 .
-المسيو «فيوله»
* قصر الخليفة المعتصم في العراق، نقلها من الفرنسية إلى العربية : محمد كرما. الايمان البيروتية (مجلة) ، م 1 / 1939) العدد 3، ص 66 - 74 .
- المقدسي «محمد بن أحمد بن أبي بكر» 947 - 990 ه_
*أحسن التقاسيم سامراء، ليدن، بریل 1909، ص 122.
- المنشئ البغدادي محمد بن احمد» 1237 ه_ - 1822 م
*رحلة المنشئ البغدادي سامراء. ترجمه من الفارسية عباس العزاوي بغداد - شركة التجارة والطباعة 1948 ص 88.
- الموسوي «عباس بن علي» 1735 .
*نزهة الجليس ومنية الأنيس.
مصر - الوهبية 1876 ج 1 ص 119 .
- «النقشبندي» ناصر.
*مشهد العسكريين في سامراء، سومر (مجلة) م 6 / 1950 ص 202 - 195 .
- الهاشمي «طه»
ص: 212
*جغرافية العراق الثانوية بغداد، دار السلام 1929 ص 123 .
-الهاشمي «د. محمد يحيى»
*خزف سامراء مفتاح الخزف الإسلامي العرفان (مجلة)، العدد 38 / 1951 ص 484 - 486 .
- هرزفلد
*معنی اسم سامراء، لغة العرب (مجلة) م 3 / 1913 ص 40-41 .
- الهمذاني «ابو الفضل أحمد بن الحسين» 1888
*شرح مقامات بدیع الزمان الهمذاني، لمحمد محي الدين عبد الحميد القاهرة، المدني طبعة ثانية 1962 ص 15 - 16 .
- الواسطي الزبيدي محب الدين أبي «الفيض 1145-1205
* تاج العروس من جواهر القاموس مصر الوهبية 1888-1889 ص 287 ، ص 272 .
- ياقوت الحموي «ابو عبد الله» 1178 - 1229
* معجم الأدباء أو ارشاد الاريب إلى معرفة الاديب القاهرة - البابي الحلبي 1936 - 1938 ج 1 ص 157.
*معجم البلدان «سامراء»، م 3 لايبزك 1866 ص 14-22 .
- اليعقوبي «احمد ابن إسحاق» 950
*تاريخ اليعقوبي، ج 3 النجف - الغري 1941 ص 999 .
*البلدان. سر من رأى. ليدن بريل ص 255 - 268 ص 366-367.
- الأماكن المقدسة في العراق، طبعة البصرة في أيام الحرب ص 28-30
ص: 213
- درر الغواص في اوهام الخواص - لايبزك 1871 طبعة قاسم الرجب طبعة ثانية - بغداد ص 180-181
- الدليل العام لتسجيل النفوس العام لسنة 957 ص 495 - 496
- دليل العراق الرسمي لسنة 1936 بغداد ص 663-664
- شعراء الحلة - أحمد النحوي بيروت دار الاندلس 1964 ص 1-49
- الثقافة (مجلة)
*سامراء، العدد (8) 1939 ص 28-31.
*سامراء، تقرير عن التنقيبات في العراق خلال 1929 - 1932.
- دليل المملكة العراقية قضاء سامراء 1935 - 1936 بغداد - الامين ص 869-871
- رسالة الإسلام (مجلة)
*اثارنا (سر من رأى) العدد 3 - 4 ، 1969 ص 234 .
- سومر (مجلة)
*سامراء م 3، 1947 ص 111-112.
* سامراء م4 1948 ص 103-112.
* سامراء م7 1951 ص 213 .
*سامراء م9 1953 ص 210 - 213 .
*سامراء م18 1962 ص 11 .
* سامراء، م19 1963 ، ص 8-9 .
ص: 214
*سامراء، م 20 1964 ، صفحة ط - ي.
*سامراء، م196521، ص8.
*سامراء، مجلد 197127 ، ص ه_.
*سامراء، م197329 ، صفحة ن - س.
*سامراء ، م 197430 ، صفحة ك - ل ص 171 - 202 .
*سامراء، م 197531 ، صفحة ز.
*سامراء، م197632 ، ص 191 - 235 .
- العمارة (مجلة)
*سامراء، العدد 5 - 6 ، م 6 / 1946، ص 69-75 .
- لغة العرب (مجلة)
*سامراء، مجلد 1911/1، ص 134 - 146، ص 137-138، ص91، ص 9 ص 161 - 170 .
*سامراء، م 1 / 1912 ، ص 339-348.
*سامراء، م2 / 1913 ، ص 515 - 520 ، ص 37 .
*سامراء ، م 6 / 1928، ص721-722.
- المقتطف (مجلة)
*سامراء م 45 / 1914، ص 373 - 381.
ص: 215
- A-
1- Abu al-soof Behnam.
Distribution of Uruk jemdet Nasr.
Iraq vol. 30. 1968.
2- AL-Adami Khalid Ahmed.
Excavations at Tell Sawwan (second season).
Sumer. vol 24. 1968. reprinted Baghdad Al-Jumhuriya press 1968 93 p. illus.
3- AL - Amid Tahir Muzzafar.
The Abbasid Architecture of Samarra in the region of AL-Mutasim and AL - Mutawakil.
Baghdad, AL - Maaref press. 1973. 288 p. illus. 'Plans' with Bibliography. transt. into Arabic.
4- AL - Asil. Naji
Lagiudad de AL - Mutasimen Qatul Reprinted from AL-Andalus vol. 12 fasc. 2. 1947.
pp: 339–357 with a foldmap.
5- AL- Azzawi Abdul sattar.
Les voutes et les aros Irakiens.
Lyon. L' Hermes 1976. 2 vols. v. 1 text v. 2 illus And plates. thesis ph. D. in Islamic Architecture.
6- Ali - Mrs. Meer Hassan
Observations on the Mussalamans of India 2 nd Edition London 1917. pp. 79.
7- Ali: Bahgat and Gabriel Albert.
Fouilles dal foustat. Paris de Boccard 1921.
ص: 216
128 p. 32 plates and 69 illus. for a comparison Between the houses and ornament of fustat and Samarra secp. 79 ff and 106 ff.
8- Alexander Constance M.
Baghdad in bygone days London 1928.
9- Anon Samarra al-Imara vil. No s 5-6 1946 p. p. 69-75 With 13 Smudges.
-B-
10- Baghdad. Iraq Govt. Dept. of Antiquities 1940 Excavation at Samarra 1936 – 1939. 2 vols.
Contents:- V. 1. Architecture and mural decoration V. 26 Objects in Arabic. 21 p. plates, ....
11- Beazley G. A. Surveys in Mesopotamia during the War Geographical journal. LV. PP: 114 - 127 1920 With 7 figsandz illus. on the ruins of Samarra.
12- Bell. Gertrudes the letters of Gertrude bell (12 th Printing) London 1947. Review of Civil administration of Mesopotamia 1920.
13- Beylie,General de. L' architecture des Abbasside au IX esiede Voyage archealogique a' Samarra dans le bassin du Tigre. Revue archealogique. Iveseree. X. 1907. PP: 1 - 18 with 11 illus. on 6
ص: 217
plates and 13 figs.
14- promeet Samarra. Voyage archealogique en Birmanie et en Mesopotamie. Paris Leroux 1907. 1 pp: 146 with 14 photos and 100 illus. publications dela Societe Francaise des fouilles archealogiques No. 2.
15- Budge. Sir Ernest A. wallis.
By Nile Tigris (London 1920).
- C-
16- Candler‹ Edmund.
The Long road to Baghdad two volumes (London 1919).
17- Coke. Richard.
Baghdad the city of peace 1935 pp. 90 – 97.
18- Chughtai M. Abdulla.
Lustred tiles from Samarra in Ashmolean Museum. Oxford Lahore. chabuk Sawaran 1935. 8 p. illus." plates.
19- Civil. Miguel.
Materials for the Sumerian Lexicon. 1979. Roma.
20- Crawfordo. G. S.
Air photographs of the Middle Easts. geographical Journal. LXXIII. 1929. PP: 497–512. with 13 illus.., And a map. Samarra pp: 498 - 500 with 2 illus.
21- Creswell. K. A. C
Early Muslim Architecture Umayyad early Abbasids
ص: 218
And Tulunids Oxford 1932-40. 2 vols.
22- A short account of early Muslim Architecture,.
Middlesex Harmondsworth 1958. Samarra pp: 259–274.
– D –
23- Dabbagh. Taqi
Hassuna pottery. Sumer vol. 21. 1965. pp: 93 – 111
24- Dimand M. S.
A Han Book of Muhammad an art Hartsdale House 1947. pp: 20. 39. 92 - 95. 116. 164 – 166 , 177. 179. 227. .
25- Samarra the ephemeral. Bulletin of the metropolitan Museum of art 1928. vol. XXIII. PP: 85-90 with 5 Illus. (of stucco ornament).
26- Studies in Islamic ornament 11. the origin of the Second style of Samarra decoration Archaeologica orientalia in memoriam Ernest Herzfeld.
New York locust valley. 1952. pp: 62 - 68. , plates v 11 - v 111 and 1 fig. forms the second part of his article published in Ars Islamica. IV.
27- Donaldson Dwight M.
Shi'ite Religion Luzac (London 1933) A short history of Islam in Persia irak vol: 12 pp: 47 - 42.
ص: 219
- E-
28- Elandsberger B.
MSL (Materialien Zum Sumerischen Lexikon) VIII / 1 V III / 2 IX. X. XI. XII. XIV. XIII 1960. , Austria.
29- Etdeghausen Richard.
The "Beveled style" in the post Samarra period.
Archaeological orientalia in memoriam ernest Herzfeld. new york locyst valley. 1952 pp 72-83. see pp: 74-75 and plates IX - X.
– F –
30- Farid Shafii
Zakharef wa turuz Samarra. (ornament and styles of Samarra) Bulletin of the faculty of arts. Fouad
1 University XIII part 2. 1951. pp: 1 – 39 with
13 plates and 35 figs.
31- Fayzee. A saf A.
A Shi'ite Creed Oxford press 1933.
32- Flury, S.
Samarra und die ornamentik der moschee des ibn Tulun. Der Islam. vol. 4. 1913 pp: 421 - 432.
33- Francis Bashir and Mahmud Ali jami Abi Dulaf Fi Samarra (the Mosque of abi Dulaf at Samarra) Sumer. 111 No. 1. pp: 60–76. 1947 with 9 Plates.
ص: 220
The results of excavations the discorety of arrow of piers next the qibla wall the Dar al - Imara behind the mihrab.
- G-
34- Gelbert A.
Lepalais de Al-Moutasim a' Samarra La Constraction moderne. XXVI. 1911. PP: 351–353 With 1. Illus. pp: 366 - 368 with 8 illus. on the Discoveries of viollet.
35-Glubb. Sir john
The Empire of the Arabic (London 1963 pp: 343 -345 - 356 – 357
36-story of the arab legion London 1952.
37- Gluck Heinrich Diez Ernst. Die Kunst des Islam (Berlin 1925).
38- Gones Commander Games Felix Journal Of a steamship. Trip to the north of Baghdad. Submitted to the Government on the 5th November 1846. Bombay Education socit's press 185.
39- Graber oleg.
The formation of Islamic art London Yale Univ. 1973-233 p. illus plans plates.
40- Graber Ernst J. and others.
Samarra in the book of Architecture of the Islamic Worlds: its history and social meaning. London ,
ص: 221
Thames and Hudson 1978 p: 250 on Samarra.
41- Guyer, S.
Samarra die Wunder stadt der Kalifen Neue Zurcher Zeitung Zurich 1917 13. 14. 15. 16. 18.
– H –
42- Harris George L.
Iraq. its people its Society. its Culture (New Haven) 1958 pp: 19. 33. 38. 96. 166. 208.
43- Herzfeld Ernest.
Archaologische Ries in Euphrat and Tigris gebiet - Samarra Kapittelz in vol. 1 Berlin 1911-1920 pp: 52 - 109 illus plans. 22 plates.
44- Bericht uber die Ausgrabungen in Samarra Archaal.
Gasellscheit z. u Berlin - April sitzung 1912.
45- Die deutschen Ausgrebungen in Samarra illus tierte Zeitung No. 3608 22 nd August pp: 335-391. Leipzig - Berlin 1912.
46- Erster Vorlaufiger Bericht uber die Ausgribungen Von Samarra - berlin. dietrich reamer 1912. 4 pp. Illus a map plates.
47- Expedition Samarra. Der Islam 111 1912 PP: 314-316.
Synopsis of a lecture before the Archaologische Gesellscheft of berlin. taken from the reichsanzeiger (eveninged) 9th April 1912.
ص: 222
48- Samarra; Aufnehmen und untersuchungen zur Islamischen Archaologye. berlin beherend 'Co. 1907. 92 p. illus. 6. plates.
49- Mitteilung uber die Arbeiten der Zweiten Kampagne Von Samarra. Dar Islam v.1914 pp: 196 – 204 with 1 full page plan.
50- Der Wandschmuck der bauten von Samarra und seine Ornamentik. berlin reamer/vonsen 1923. 236 p. 321 text illus and 101 plates.
51- Die Malereien von Samarra. berlin Reimer 1927 111 p. 83 text illus. 88 plates.
52- Geschichte der stadt Samarra. berlin Dietrich Reimer. 1948. 290 p. 55 text illus. 33 plates 5 maps.
53- Hilli. Philip k.
History of the arabs Macmillan (London 1937).
54- Hollister. john Norman.
The ShiA Of India (London 1953) pp. 87 - 89.
– I –
55- Iraq Directorate of Antiquities. Bab al Ghaibah (Door of Desperation) at Samarra. Baghdad Government press 1938. 7 p. +9 (English + Arabic) 12 plates.
56- Hafriyat Samarra 1936-1939 (Excavation at Samarra 1936-1939) Z vols: V: ar Riyaza
ص: 223
Wa' 1 Zakharif pp. I and 56 with 120 plates and 26 figs and Summary in English 25 p. v. 2.
AL-A thar al- Mangula pp. 21. with 144 plates And Summary in English 13 pp. Baghdad Govt. Press 1940.
57- Iraq. Ministry of Education.
Reporton Excavation 1933 during 1929 - 1932.
58- Ireland Philip Willard.
Iraq. a study in political Development (London 1938) pp. 208.
-K-
59- Keiser. Helen
Temple und Tvrme Der Sumerea 1979 W. Germany.
60- Kinnier john Macdonald.
Journey through Asia Minor Armenia Koordistan in the years 1813 1814 (London 1818)
61- Kuhnel. Ernst.
Islamishe Kleinkunst (berlin 1925).
62- Kuhnel. Ernst.
Samarra berlin. 1939. 24 p. illus. 20 plates And 2 figs.
63- Lamm. Carl johan
-L-
Das Glas Von Samarra berlin Reimervohsen 1928.
ص: 224
64- Le Strang Guy.
The lands of the eastern Caliphate
(cambridge 1930).
65- Lloyd Setou.
Jausaq AL-Khagani at Samarra a new construction Iraq. Vol. 10 1948.
66- Lloyd Seton.
Ruined Cities of Iraq. (oxford univ. press 1942). Pp. 33.
67- twin rivers. Oxford Un press 1943.
68- the palace at the Abbasid Caliphs at Samarra journ. Of the roy. Inst. of British Architects 1949.
3 rdseries. LV 1. PP: 530-534 withe 5 illus on a Model of the immense palace of al-Mutasim in Iraq Museum of Antiquities.
69- Longrigg. Stephen Hemsley.
Iraq 19001950- Apolitical Social Economic History (London 1953) pp. 13.112.125.
70- Longrigg Stephen H. Stoakes Frank.
Iraq (London 1958) pp. 62. 74. 182.
- M -
71- Migeon Gaston Manueld art Musulman (Paris1927)
ص: 225
-R-
72- Richmond. Ernest Tatham Moslem Architecture 623 to 1516. some causes and Consequences. London the royal Asiatic society. 1926. 159 p.
73- Ross
In the journal of the royal Geographic society. X 1. PP 128.
- S -
74- Sarre. Friedrich:
Die Aufstellung von Samarra in Kaiser Friedrich Museum. Berichte aus den preussischen Kunstsammlungen XL 111. 1922 PP: 49-60 And Abb. 41 - 56.
75- Samarra in Mesopotamia; a Caliph's Residence of the Ninth century. art in America X 111. 126. pp: 82-926 With 3 plates.
76- Samarra in Mesopotamien eine Kalifenresidenz des 9 jahrhunderts 1926. Forschungen und Fortschritte 11. p. 43. Repart of alcture given on 17th February 1926.
77- Schwarz pual.
Die Abbasiden - Residenz Samarra; Neue historisch geographische Untersuchungen. Leipzig. Wignad 1909. 42 p. Quellen and
ص: 226
Forshungen zur Geschichte der Erdkunde, 1.
78- sourdel - thomine Janine.
Samarra. In the book. die Kunst des Islam Berlin Propylaen Verlag. 1973. pp: 218-226.
79- Stark Freya.
Baghdad Sketches. First edition London 1937.
80- Staatliche Museenin berlin.
Samarra berlin Otto von Holton - Islamische Abteilung 24 p. 31 iulls.
-T-
81- Tavernier' J. B.
The Six Voyages of Tavernier Through Turkey into Asia. (made into English by J. P. London 1676).
82- Thureau – Dangin, F.
Tablettede Samarra. Revued' Assyriologie et d' Archealegie orientales vol. 9. 1912 pp: 1 – 4.
83- Tulane E.
Repertoire of Samarra Style journal of near eastern Studies (JNES) VOL. 3. 1944 PP: 47 – 72.
-U-
84- Ussher john
London to Persopolis including Wanderings in Daghestan Georgia Armenia Persia (London 1865).
ص: 227
-V-
85- Viollet. H.
Description de palais de al - Moutasim fils d' Har Oun - al-Rashid Samarra et de quelques monuments Arabes peu connus de la Mesopotamie. Memoires Presents per divers Sarvants al' Academiedes Incur. et Belles - Letters × 11. 1909 pp: 567 - 594 with 22 plates And 7 figures.
86- Viollet. H.
Lepalaisd'al - Mutasim fils d' Haroun - al-Rashid A Samarra et de quelques monuments arabes peu Connus dela Mesopotamie - comptes rendus del 'Acad. des Incur. et belles - letters 1909. pp: 370-375 with 6 illus.
87- Fouilles a Samarra en Mesopotamie. Un palais Muslelman du 1 × e siècle. Memoires presents Par divers savants a L' Academie des Inscr. et belles - letters 11. 1911 pp: 685 - 717 with 23 plates (1 cel.) and 11 figures.
88- fouillesa Samarra. ruinesdupalais d'
Al-Moutasim. comptes rendus de L' Academie des Inscriptions et belles - letters 1911. pp: 275-286. With 7 illus.
89- Viollet. H.
Samarra article in the Encyclopedia of Islam IV. 1925. PP: 131–133.
ص: 228
- W -
90- Wilson sir Arnold T.
Loyalties. Mesopotamia vol - 11 1917-1920 PP. 170.
-Z-
91- Zaki Mohammad Hasan.
Samarra - a th - thaqafa vol. 1. 1939. No. 8. M:
28-31 with 6 Illus.
92- Samarra in Sumer Journal:
Vol. 16 p 62 1960.
Vol. 21 pp: 69 – 83 1965.
Vol 22. pp: 83-99. 1966.
Vol 23. pp: 183-188. 1967.
Vol 25 pp: 143 – 162 1969.
Vol 26 pp: 277-284 1970.
Vol 30 pp: 171-202 1974.
Vol 32. pp: 189 - 194 1976
ص: 229
ص: 230
المجلد الثالث والأربعون سنة 1984
دار رقم (1) سامراء والشارع الأعظم
في الفترة 8 / 6 / 1981 ولغاية 1/ 2 / 1982
ناهدة عبد الفتاح
(باحث علمي)
1- مقدمة عامة
نظرا لأهمية مدينة سامراء الأثرية والسياحية، واحتوائها على شواهد بنائية من تخطيط المدينة وعظمتها العمارية واتساع رقعتها، حيث ضمت الكثير من العناصر الزخرفية، وكونها كنزاً حضاريا لمدينة إسلامية قد لا يجود التاريخ بمثلها، لأنها تمثل فترة زمنية محددة ومتميزة بعطائها الثر ومحافظتها على مكوناتها.
ولقد بدأ العمل في هذه المدينة بناء على توجيهات السيد الرئيس صدام حسين (1) لإحيائها وإعادتها إلى الظهور بمظهرها السابق لتتحدث للأجيال عما فيها من مظاهر التقدم في البناء والتخطيط الهندسي، والتنسيق العماري، في تنظيم الشوارع وتوزيع القصور والدواوين والثكنات والأسواق كل على حدة، وبينهم المتنزهات وحدائق الحيوانات وحلبات السباق.
بدأ هذا المشروع أعماله في عام ،1981، وتم تكليفي بمسؤولية التنقيب في دار
ص: 231
رقم (1) الواقع في نهاية الشارع الأعظم، وبدأت بالعمل يوم 1980/6/8 شاركني فيه لعدة أسابيع الطالب الآثاري المتدرب كمال عبد الرحيم.
استغرق الكشف عن جميع مرافق هذه الدار الكبيرة مدة تسعة أشهر فقط، بما فيها الفترة اللازمة لتهيئة المكان ومستلزمات التنقيب وتشغيل العمال، حيث كان معدل عدد العاملين عشرين عاملا، وقد ساعدنا استخدام الآلات الحديثة في إنجاز هذا العمل بالفترة المذكورة أعلاه.
2 - دراسة تاريخية لمدينة سامراء (1).
تقع مدينة سامراء على بعد (130) كم شمالي بغداد، وتمتد مسافة (35 كم) على ضفة نهر دجلة الخالد طولاً، وتشغل ما بين 2-4 كم عرضا .
كان لبناء مدينة سامراء الإسلامية أسباب كثيرة منها استخدام الخليفة المعتصم بالله (218 – 227ه_) (733- 842م) لعدد كبير من الجند الأتراك وسوء تصرفاتهم التي بعثت لاستياء في نفوس سكان مدينة بغداد، مما دعاهم إلى الشكوى إلى الخليفة،
ص: 232
ولأسباب سياسية اقتنع الخليفة المعتصم وعزم على هجر بغداد والانتقال إلى أية منطقة أخرى تتوفر فيها أسباب السكن الخالية من المشاكل ليجعلها عاصمة لملكه وسكناً له ولحاشيته. فخرج وأخذ فريقاً من ذوي الخبرة بشؤون العمارة واختيار الموقع الجغرافي والصحي والاقتصادي لبناء عاصمة جديدة يستقر فيها، يذكر اليعقوبي وصفاً دقيقاً للبحث عن هذا الموقع الجديد فيقول: (وعزم على الخروج من بغداد فخرج إلى الشماسية) (1).
ولكن لقربها من بغداد وضيقها فمضى إلى البردان(2) واقام فيه أياماً وأحضر المهندسين ثم لم يرض الموضع ، فصار إلى موضع يقال له باحمشا(3)، فقدر هناك مدينة على دجلة وطلب موضعاً يحفر فيه نهراً فلم يجده ، فنفذ إلى القرية المعروفة بالمطيرة(4)، فأقام بها مدة ثم مد إلى القاطول (5).
وبعد ان سكن فيه فترة من الزمن شاء أن ينتقل منه، فاختار موقع سامراء حيث لم يجد خيراً من هذا الموقع الجغرافي الذي يمكنه من إدارة دفة الحكم لكافة أجزاء المملكة، إضافة إلى العوامل الصحية، وطيب الهواء وكثرة المياه في نهر دجلة وامتدادها على مرتفع صخري يبعدها عن خطر الفيضانات.
استمر ازدهار سامراء وتوسعها وعمرانها، وزاد في عهد الخليفة المتوكل
ص: 233
232ه_ (846م)؛ إذ أضاف إليها قصوراً كثيرة، وأمر بهدم المسجد الجامع حيث ضاق بالمصلين، وشيد مسجداً جامعاً لا يزال حتى يومنا هذا يشمخ ببنائه وملويته.
وفكر الخليفة المتوكل أن ينقل عاصمته إلى بغداد وذهب إليها، فهي المدينة الأم التي نشأ فيها الآباء، ولكنه غير رأيه ليبتعد عن المشاكل التي ربما تثيرها عودته مع القواد والجند، ثم ذهب إلى الشام ليجعلها مقرا لحكمه، ولكنه عاد واستقر رأيه على بناء مدينة مستقلة يسكنها ويحكم فيها.
وقد أورد اليعقوبي وصفاً دقيقاً لهذا القرار حين ذكر أن المتوكل أراد أن يبني مدينة يسكنها ، ويخلد اسمه في بنائها وسلك في ذلك مسلك من سبقه من الخلفاء في إنشاء مدينة تسمى باسمهم، واستدعى محمد بن موسى المنجم وعدداً من المهندسين، وطلب منهم أن يختاروا له مكاناً مناسباً يصلح لبناء مدينة جديدة، فاتفقوا على اختيار موقع الماحوزة شمال سامراء، وأخبروه بأن المعتصم كان قد عزم على بناء مدينة في هذا الموضع، وتوسيع مجرى نهر ،قديم، فاقتنع وبدأ بالبناء سنة (245ه_ - 859 م) وحفر النهر وسط المدينة، ووضع مخططاً لقصوره ومنازله، ووزع القطائع على أولياء العهد من بعده وأولاده على امتداد الشارع الأعظم وبعد أن تم البناء اطلق على هذه المدينة اسم المتوكلية أو الجعفرية، وأصبح البناء سلسلة متصلة تبدأ منها وتصل إلى الدور والكرخ ، ثم إلى سر من رأى، ولم يستغرق هذا المجهود الكبير سوى سنة واحدة، وقد روعي في بنائها أن تعزل الأسواق على حدة، وشيد المسجد الجامع الذي يدعى جامع أبي دلف، وانتقل المتوكل إليها في أول يوم من شهر محرم سنة سبع وأربعين ومئتين، وقد أحس بعد أن حقق أمنيته بالسعادة فقال : (... الان علمت اني ملك؛ إذ بنيت النفسي مدينة سكنتها ...) (1).
حقا ان مدينة الجعفرية تقع في بقعة جميلة جداً على بعد خمسة عشر كيلو مترا شمال
ص: 234
سرّ من رأى، وتمتد على نهر دجلة فتشكل جزيرة تحيطها المياه من جميع أطرافها، وهي مدينة تصلح لغرض النزهة والراحة، وليبتعد عن مدينة سر من رأى.
ولكن فرحة المتوكل وسعادته لم تطل بهذه المدينة الجديدة الجميلة حيث اغتالته يد الغدر والخيانة(1) بعد مضي تسعة أشهر وثلاثة أيام من انتقاله اليها، وكان ذلك في 3 شوال من السنة نفسها.
وبقتله قضي على هذه المدينة التي شيدت في فترة قصيرة وسكنت بفترة قصيرة، حيث هجرت في زمن الخليفة المنتصر ابن المتوكل (247 - 248 ه_) (861-862 م). وامر بنقض مبانيها وعاد إلى مدينة سر من رأى، وهنا صح قول المتوكل فقد بنى المدينة لنفسه وسكنها هو وحده.
وتعاقب على حكم مدينة سامراء بقية الخلفاء الثمانية الذين حكموها فجاء المستعين والمعتز والمهتدي، وأخيراً جاء إلى الحكم الخليفة المعتمد أحمد بن المتوكل (256 - 279ه_) و (870- 89 م) ، والذي هجر مدينة سر من رأى وانتقل إلى بغداد بعد أربعة وخمسين عاما من إنشائها، وهذه من الحالات النادرة في التاريخ؛ إذ يندر أن تبنى مدينة بهذه السعة والقصور خلال فترة قصيرة وتهجر، ولكننا عندما نعلم السبب في تركها والعودة إلى بغداد نجد حالات أخرى مشابهة، وذلك لان النهر الذي حفر ليوصل المياه من دجلة إلى مدينة سامراء والمتوكلية فيما بعد لم يستمر في إيصال الماء فقد
ص: 235
فشل هذا المشروع (1) فلم تعد المياه تسقي البساتين وتسد الحاجة، فهجرت المدينة كما هجرت مدينة واسط (2) قبلها، إذ لولا هذه الظاهرة لاستمر السكن فيها بالرغم من انتقال الخليفة ومقر الحكم منها.
اشتهرت هذه المدينة في كتب التاريخ والادب وذاع صيتها؛ لما حوته من قصور ومسجدين تعد آثارهما من روائع العمارة الإسلامية، فالمسجد الجامع في قلب المدينة يحتل حيزاً كبيراً وتتجلى فيه الظواهر العمارية للمسجد من حيث السعة والفخامة والأسوار الخارجية ذات الأبراج والمئذنة الملوية الفريدة في نوعها والتي ظهرت لأول مرة بهذا الشكل.
وجامع أبي دلف في شمال سامراء يعتبر نموذجاً مصغراً للمسجد السابق ذكره وملويته.
وأما شوارعها فتميزت بالسعة والاستقامة في الامتدادات، حيث بلغ عرض الشارع الرئيس مئة متر، وهناك فروع تتراوح بين (75، 50، 35) كما يبدو من الخرائط الجوية للمدينة وبعض القياسات التي قمنا بها لبعض الشوارع والفروع أثناء أن عملنا في التنقيب.
وقد برزت سبعة شوارع مهمة تقسم المدينة، أهمها الشارع الأعظم أو شارع السريجة، وشوارع فرعية: شارع أبي أحمد، وشارع الحير، وشارع برغامش القائد التركي فيه قطائع الأتراك والفراغنة لا يخالطهم أحد من الناس، وشارع الحير الجديد وشارع الخليج، ويمتد هذا الشارع على نهر دجلة حيث ترسو الفرض
ص: 236
والسفن والتجارات التي ترسل من بغداد وواسط وكسكر ومن أرض السواد من البصرة والأبلة والأهواز (1) .
وعلى الشارع الأعظم وفروعه تمتد القصور والدور.
وكذلك على نهر دجلة، إذ لا تزال بقايا بعضها تقاوم تلاطم المياه، ومن هذه القصور قصر الأحمر والاحمدي وقصر أشناس... والأفشين والبديع والبرج وقصر بستان الايتاخية وبلكوارا والبهو والتل والجص وقصر الجعفري والجوسق وقصر حبش والحير وحمران والدكة والشاه و شبداز والشيدان والصبيح والمليح والصوامع وقصر العاشق (المعشوق) والعمري والعروس والغريب والغرد والقلائد واللؤلؤة والمختار والمحمدية والمتوكل والمحدث والهاروني والوحيد والوزيري (2).
وقد تغنى الشعراء بوصف هذه القصور وللبحتري قصائد كثيرة في ديوانه تصف لنا هذه القصور وبعض الحوادث التي جرت فيها.
وهناك خمسة أسوار متفرقة لا تزال بقايا بعضها ظاهرة، منها سور الحير الذي أنشأه المتوكل حول حير الوحوش، وسور عيسى مقابل المسجد الجامع، وسور أشناس(3) يقع في منتصف الطريق بين قصر الخليفة وجامع أبي دلف شمالي سامراء الحالية وغرب سامراء القديمة، وسور المتوكلية الذي يحيط بمدينة المتوكلية والسور المآذي الذي يبدو على الطريق عند الذهاب من بغداد إلى سامراء، وبقايا حصن في جنوب سامراء يدعى حصن القادسية، وثلاث حلبات لسباق الخيل تقع مقابل دار الخليفة تميزت بأشكالها المبتكرة.
ص: 237
امتازت هذه الجوامع والقصور والأبنية بمساحاتها الواسعة وزخارفها الغنية التي ظهرت في نقوش الأفاريز التي تزين قصر الخليفة، والتي ظهر جزء منها عند إجراء التنقيبات فيه وفي قصور مدق الطبل وغيرها، وهذه الزخارف الجصية تمثلت فيها طرز سامراء الثلاثة، فالطراز الأول (أ) يمثل مرحلة امتداد للزخارف السائدة في العصور السابقة، وتمتاز بعمق الحفر وإبراز ورقة العنب وتفرعاتها (1).
والطراز الثاني (ب) يتميز بقلّة العمق والميل قليلاً إلى التسطح في النقش.
أما طراز سامراء الثالث (ج) فقد انتشر انتشاراً واسعاً في مباني سامراء، وأطلق عليه اسم النقش المشطوف أو المقطوع، تميز بنقوشه البسيطة التي تصب في قوالب تتلاءم والسرعة التي بنيت بها المدينة.
والتي تدل على الرفاه وسعة العيش، واعتبرت من الظواهر العمارية الجديدة التي انتشرت في بعض أنحاء العالم الإسلامي، حيث نجد أن هذه النقوش انتشرت في مصر في جامع ابن طولون، كما انتقلت الملوية من سامراء إلى نفس الجامع إلا أنها كانت أصغر منها حيث ظهرت الملوية لأول مرة في مدينة سامراء، وانتقلت منها إلى مصر (2).
وقد نمت في سامراء الصناعات الكثيرة التي اشتهرت باسمها فيما بعد، خاصة الفخار والخزف بأنواعه المتعددة والخزف ذو البريق المعدني، الذي نشأ وتطور في هذه المدينة، والخزف المبقع الذي اشتهرت به سامراء وعرف فيها لأول مرة، وكذلك القاشاني ذو النقوش الجميلة، حيث انتشر منها ووصل إلى جامع القيروان في تونس،
ص: 238
حيث يزين محرابه عدد منه.
وبعد أن وصلت هذه المدينة إلى القمة في فترة قصيرة حتى أصبح بعض المؤرخين يصفها بأنها من أعظم بلاد الله بناء وأهلاً ... ولم يكن في الأرض أحسن ولا أجمل ولا أوسع ملكاً منها»(1)، وقد أصبحت سُرَّ من رأى تسمى زوراء بني العباس، ثم تبدل حالها في القرن الرابع الهجري فوصفت بانها (خراب ربما يسير الرجل في مقدار فرسخ منها لا يجد بها داراً معمورة) (2).
وتبقى هذه المدينة على هجرها سنين طوال محافظة على مبانيها المطمورة تحت الأنقاض، وخاصة القسم الشمالي منها، حيث لم تتعرض للسكن فوقها والتخريب كما تعرضت غيرها من المدن كمدينة البصرة 14 ه_ / 635م، والكوفة 17ه_ / 638م بغداد 145ه_ / 762 م، حيث استمر السكن ،فوقها، وحدثت تجديدات كثيرة وضاعت معالم أكثرها.
الصورة

ص: 239
وفي نهاية حكم العثمانيين عادت الحياة إلى هذه المدينة وبدأت الحياة تدب فيها من جديد، حيث نشأت على أنقاض القسم الجنوبي منها قرية صغيرة حول ضريحي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، ثم نمت وتوسعت هذه القرية تدريجياً ولا تزال في اتساع مستمر.
أ- الشارع الأعظم
وهو الشارع الرئيس في المدينة ويسمى شارع السريجة، كان يمتد من المطيرة إلى وادي إسحق بن إبراهيم واستمر من الجنوب من سور أشناس على امتداد القطائع التي وزعت للقواد، وقسم المدينة إلى قسمين حتى يصل إلى مدينة المتوكلية، فيذكر اليعقوبي : ( ومد المتوكل الشارع الأعظم من دار أشناس التي بالكرخ والتي صارت للفتح بن خاقان ثلاثة فراسخ إلى قصوره، وجعل دون تصوره ثلاثة أبواب عظام جميلة، يدخل منها الفارس برمحه، وأقطع الناس يمنة الشارع ويسرته، وجعل عرض الشارع الأعظم مئتي ذراع، وقدر أن يحفر في جنبي الشارع نهرين يجري فيها الماء من النهر الكبير الذي يحفره) (1).
واذا تأملنا الخارطة الجوية لمدينة سامراء نلاحظ في الشكل (1) أن الشارع الأعظم يبدأ من سور أشناس جنوباً، بعرض يعادل نصف ما عليه في امتداده الباقي أي حوالي خمسين متراً، ويسير باتجاه الشمال حتى نهاية قطيعة إبراهيم بن رياح، ثم يسير باستقامة واحدة وعرض مئة متر حتى باب البستان عند السور الخارجي لمدينة المتوكلية والذي يمتد بخط متكسر ، ويصل ما بين نهر دجلة ونهر القاطول ويعزل مدينة المتوكلية عن مدينة سُرَّ مَن رأى.
ومَن يسير في هذا الشارع الآن سيلاحظ - كما لاحظت في خلال عملي في التنقيب في واحد من دور هذا الشارع - أن الأطلال الباقية للدور والقصور الممتدة
ص: 240
على جانبيه بارتفاعات متفاوتة كأنها سلسلة تلال تشكل بعضها مخططاً لقصر أو دار كبيرة، كما يظهر من خلال التراكمات والأنقاض داخلها، وبعضها الآخر يقتصر على السور الخارجي فقط، ويخلو داخله من الأنقاض مما يدعو للاعتقاد بأنّ هناك مساحات واسعة كبساتين بين الدور أو ربما أسوار لدور لم تشيد، تمتد أمامها منخفضات على الجانبين، يبدو أنها محفورة تمتلئ بالرمال مما يدل على ترسبات المياه الجارية فيها، والتي كانت تصل إليها من النهر الجعفري.
واشتهر الشارع الأعظم بعرضه واستقامة تخطيطه لمسافة طويلة تبلغ سبعة كيلو مترات ونصف الكيلو متر، وان امتداده بهذا الشكل يضفي أهمية على مدينة المتوكلية الجميلة ومراعاة التنسيق في تخطيطها.
وقد قمنا بمساعدة المساحين في المشروع بقياس عرض هذا الشارع بين آخر دارين متقابلين في نهايته، فظهر أن عرضه كان مئة وأحد عشر متراً، وعليه يكون عرض الشارع مئة متر، وعرض كل ساقية على جانبي الشارع نصف متر، وبين الساقية وواجهة الدار خمسة أمتار.
ب- موقع الدار رقم (1) من الشارع الأعظم
تقع هذه الدار في القسم الشمالي الشرقي من مدينة سامراء على الشارع الأعظم وتبعد مسافة سبعة عشر كيلو متراً عن المسجد الجامع في سامراء، وقبل الوصول إلى جامع أبي دلف بمسافة ثلاثة كيلو متر، وتمثل بقايا هذه الدار آخر بناء حديث، تبدو من بعده الأرض منبسطة تماماً حتى نصل جامع أبي دلف، الا ان الخارطة الجوية السامراء يبدو فيها استمرار البناء حتى المتوكلية واتصال الدور بها الشكل (1) السابق.
لقد تمكنا من تحديد هذه الدار على الخارطة (1)، وظهر أنها تقع ضمن مستطيل
ص: 241
يمتد بين نهر دجلة ونهر القاطول ، ويشكل قطيعة تعود للقائد التركي برغامش، حيث يقع قصره الذي تبدو آثاره على نهر دجلة، وتمتد بقية الدور التي يسكنها أتباعه، وهذه واحدة منها على جانبي الشارع الأعظم الذي يقسم القطيعة المذكورة إلى قسمين وكذلك بقية القطائع.
ج - شكل الدار ومساحتها وتاريخها
إن هذه الدار تشكل مستطيلاً طوله مئتان وسبعة وعشرون مترا، وعرضه مئة وتسعة أمتار، وبذلك تكون مساحته أربعة وعشرين ألفاً وسبعمئة وثلاثة وأربعين متراً مربعاً.
يعود تاريخ هذه الدار إلى زمن الخليفة المتوكل بين سنتي 232 - 247 ه_ 847- 861م . وقد قام بمدّ الشارع الأعظم نحو الشمال ليوصله إلى المدينة المتوكلية كما ذكرنا سابقاً، والتي تم إنشاؤها سنة سبع وأربعين ومئتين، عليه نستطيع ان نؤرخ بناءها بالفترة الاخيرة من حكمه، وربما سنة 346 ه_ ( 860 م).
-- التنقيب في دار رقم (1)
بدأ التنقيب في هذه الدار عند بدء مشروع الإحياء الأثري لمدينتي سامراء والمتوكلية الأثريتين، وأطلق عليها دار رقم (1) ، لأنها أول دار بدأ العمل بها في الشارع الأعظم ولوقوعها في بدايته من جهة الشمال، وكان أن جرت تنقيبات سابقة في 1936 - 1939 في عدة دور نشرت في وقتها (1) ، الا ان هذه الدار لم تجر فيها تنقيبات ولم تمسها معاول الحفارين من قبل، واستطعنا أن نحصل على خارطة لها كاملة وبسيطة، تعتبر نموذجاً لشكل الدور التي شيدت في سامراء باحتوائها على المرافق الضرورية والترفيهية .
ص: 242
ولقد تم قبل البدء بالتنقيب تصوير الموقع وإجراء مسح وحددت مساحته، وتم تقسيمها إلى مربعات مساحتها (20م× 20م) ، وبُدئَ بالتنقيب في المربع الأول الذي أطلقنا عليه رقم (أ) في وسط الواجهة.
ظهر المدخل واستظهرنا الواجهة الأمامية، وبدأ الكشف عن الوحدات البنائية، والصحون التي فيها والساحات التي تفصلها عن بعضها، والحديقة الواسعة التي تقع خلفها.
وقد كشف لنا المخطط الكامل لهذه الدار (الشكل 2 مخطط) انها تحتوي على مدخلين رئيسين أحدهما في الضلع الغربية، وهو الأكبر (1) (الشكل 3) والآخر في الضلع الشرقية (35) ، ومدخل ثانوي ذو دهليز طويل (10) والى جواره وحدة بنائية صغيرة كاملة من (11-18) سميت بيت الخدم وخلفها حديقة (20) تؤدي إلى قاعة الاستقبال من خلال ثلاثة مداخل ذات طلعات ودخلات (21-32)، وتتصل من ناحية الشمال ببيت يحتوي على حجر حول صحنين، وعلى حمام وكنيف أطلقنا على هذه التشكيلة البيت الرئيس تسكنه العائلة صاحبة الدار.
إلى جنوب هذا البيت تقع وحدة بنائية دلت الآثار التي عثرنا عليها فيها انها مطبخ رئيس ومخزن (37-42).
الصورة
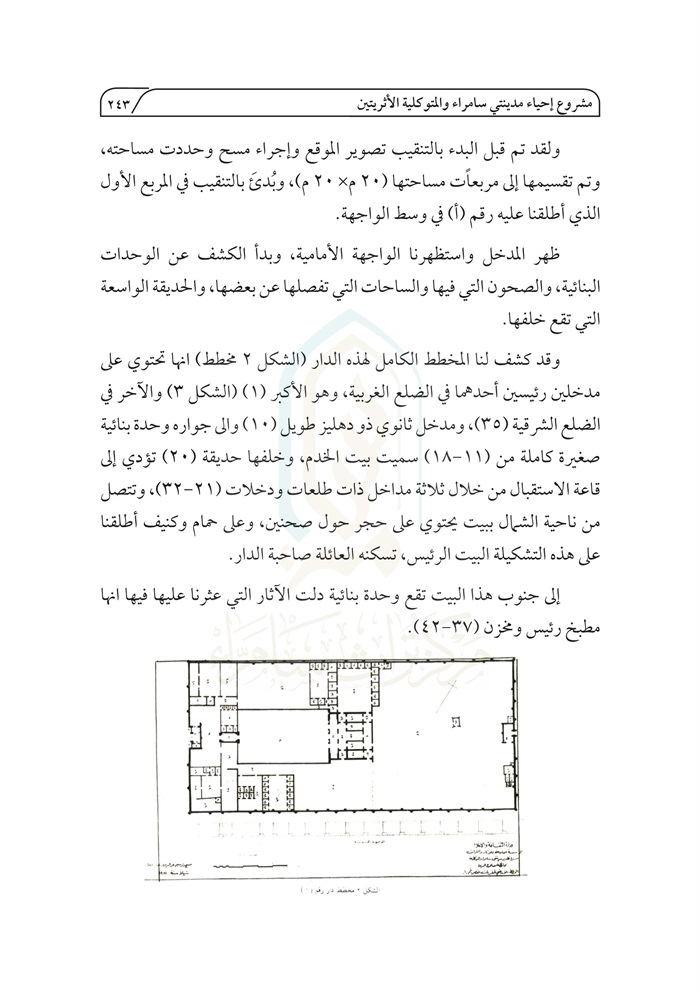
ص: 243
وعلى الضلع الجنوبية الغربية للدار يقع اسطبل للخيول 72 - 80، تتصل ضلعه الشرقية بمربط للخيل 82 - 88 .
ويقع أعلاه وحدة بنائية 89 - 101 أطلقنا عليها بيت السواس، وفي الضلع الشرقي بيت صغير (103 - 108) لتربية الدواجن والطيور.
أ- السور الخارجي
يحيط بهذه الدار سور مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب بطول (227 متراً)، ومن الشمال إلى الجنوب (109) متراً)، مكون من جدار ثخنه (60 / 1 متراً) ومعدل ارتفاع الباقي منه يتراوح بين (20 / 1) (1/20) متراً، في نهايته السفلى نجد إفريزاً مائلاً يصل بين الجدار والأرض، ربما هو بقايا دكة على الواجهة الأمامية على جانبي الباب، التي بقي جزء واضح منها بجانب الضلع الشمالية الغربية من الباب عرضه (70 سنتمتراً)، كما ظهر أثناء التنقيب أو لتقوية الوجه الخارجي للسور.
يقوي هذا السور ويزينه من الخارج تسعة واربعون برجاً بضمنها الأبراج المحيطة بالأبواب أربعة منها تشكل الأركان الأربعة للدار قاعدتها مربعة ضلعها (3/80 متر)، يرتفع على كل منها عمود بشكل ثلاثة أرباع الدائرة الشكل 4 ) .
أما بقية الأبراج فتتوزع على الأضلاع الأربعة لها قاعدة مستطيلة طولها (3 أمتار) وعرضها (80 / 1 متر) ، وعلى ارتفاع متر واحد للقاعدة، يستند عمود نصف دائرة قطره (3 أمتار)، وعلى مسافات متفاوتة، فعلى سبيل المثال كما في (الشكل 4) في الجزء الجنوبي الغربي من برج الباب إلى البرج الأول (20 / 11) مترا، وبين هذه والبرج الثاني (80 / 13 متراً) وبعده مسافة (14 متراً) إلى الركن الجنوبي الغربي، فيكون مجموع الأبراج في الضلع الغربية والذي تقع فيه المدخل الرئيس ستة ابراج، اما الضلع الشرقية فتحتوي على ثمانية ابراج وفي الضلع الشمالية خمسة عشر برجاً، وفي الجنوب ستة عشر برجاً لا تزال بقاياها قائمة.
ص: 244
يسند هذا السور من داخل الدار دعامات مستطيلة الشكل عددها خمس وعشرون دعامة خمس منها في الضلع الشرقية، وفي الضلع الشمالية سبع دعامات
الصورة
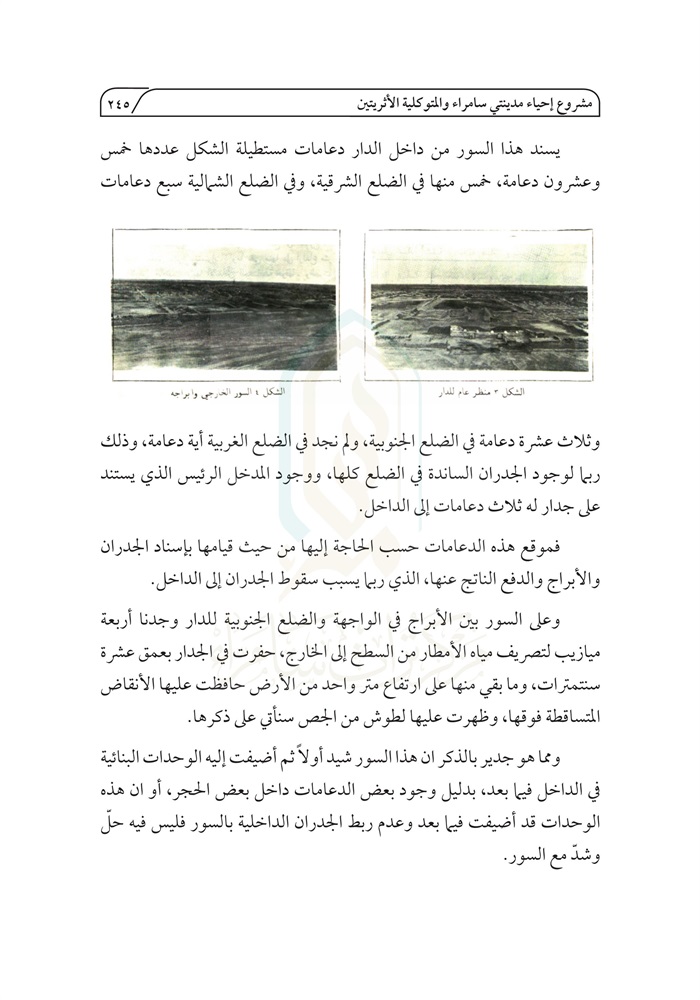
وثلاث عشرة دعامة في الضلع الجنوبية، ولم نجد في الضلع الغربية أية دعامة، وذلك ربما لوجود الجدران الساندة في الضلع كلها، ووجود المدخل الرئيس الذي يستند على جدار له ثلاث دعامات إلى الداخل.
فموقع هذه الدعامات حسب الحاجة إليها من حيث قيامها بإسناد الجدران والأبراج والدفع الناتج عنها، الذي ربما يسبب سقوط الجدران إلى الداخل.
وعلى السور بين الأبراج في الواجهة والضلع الجنوبية للدار وجدنا أربعة ميازيب لتصريف مياه الأمطار من السطح إلى الخارج، حفرت في الجدار بعمق عشرة سنتمترات، وما بقي منها على ارتفاع متر واحد من الأرض حافظت عليها الأنقاض المتساقطة فوقها، وظهرت عليها لطوش من الجص سنأتي على ذكرها.
ومما هو جدير بالذكر ان هذا السور شيد أولاً ثم أضيفت إليه الوحدات البنائية في الداخل فيما بعد، بدليل وجود بعض الدعامات داخل بعض الحجر، أو ان هذه الوحدات قد أضيفت فيما بعد وعدم ربط الجدران الداخلية بالسور فليس فيه حلّ وشدّ مع السور.
ص: 245
ونجد أن مادة البناء لهذا السور تتألف من كتل كبيرة مضغوطة من الجص إلى ارتفاع متر واحد، وبعدها استخدام الطوف الطين بشكل صفوف منتظمة، تمتد على طول السور، وان الجدار قد طلي من الداخل والخارج بالجص، كما يبدو من بقاياه في أسفل الجدران.
ب- المداخل والأبواب
للسور الخارجي مدخلان أحدهما رئيس كبير يقع في الضلع الغربية، والثاني مدخل أصغر منه يقع في الضلع الشرقية، وفي الضلع الجنوبية وجدنا كسرة كبيرة في السور، يغلب على الظن انها مدخل ثالث يؤدي إلى الاسطبل، فقد لحقها تخريب يجعلها ممراً للمزارعين الساكنين بالقرب من هذه الدار.
تميز المدخل الرئيس عن بقية المداخل بسعته ووقوعه في الضلع الغربية، وهذا الاتجاه من المواضع الجيدة للأبواب، إذ يواجه الريح الغربية الباردة.
يمتد هذا المدخل مسافة (60 / 11 متراً) ويقسم إلى ثلاثة أقسام الوسطى اعرض من الجانبين حيث يبلغ (10، 4 متر) ويكون العتبة (1)، وهي مبلطة بالطابوق الفرشي قياس (28× 28 ×8) ، ويقع على جانبيها برجان طول البرج الجنوبي (70 ، 3 متر)، والشمالي ( 80 ، 3 متر)، يخرجان عن سمت الجدار بمسافة (25 ، 1متر)، ويتصل كل برج بالسور المجاور له بواسطة التعشيق، حيث قطع من جدار السور من الأعلى (30 سم) ، ومن الأسفل (30 سم)، وبقي لسان بطول متر واحد حيث إن ثخن جدار السور (60 / 1) على مسافة (35 سم ) داخل البرج، فظهر التعشيق بين السور والبرج، وبترك فاصل بينهما، فقد روعي في هندسة البناء حساب التمدد ووجود فارق بين كتلتين مختلفتين في نوع مواد البناء والوزن، حيث إن الأبراج مبنية بالطابوق والجص ، وجدار السور مبني بالطوف وكتل اللبن الجصي. فالربط بينهما بهذا الشكل يقاوم حركة الباب الكبيرة وهبوب الرياح (الشكل 5).
ص: 246
وعند نهاية العمودين من الداخل وجدنا قاعدتي عمودين مربعین تقسمان المسافة المتبقية إلى ثلاثة أقسام، ويبدو أنها كانت تحمل العقود عليها .
ومن ضخامة هذين البرجين وكثرة الأنقاض المتراكمة في المدخل نستطيع ان نتصور ان هذا المدخل كان عاليا ، وعلى سقفه قبة كبيرة في الوسط، وعلى جانبيه قبتان صغيرتان، لأن المسافة تشكل مربعاً ومن السهولة تحويله إلى قاعدة قبة بالمقرنصات في الزوايا، ويصل بين البرجين من الأعلى أسكفة ربما تمتد فوق جسر خشبي؛ لعثورنا أثناء التنقيب على قطع خشبية، يبدو انها كانت مستخدمة في البناء لهذا الغرض (الشكل 6) .
الصورة

يغلق هذا المدخل بواسطة باب خشبي كبير سنأتي على ذكره.
يؤدي هذا الباب (1) إلى مجاز (4) مستطيل الشكل طوله اثنا عشر متراً وعرضه خمسة أمتار، تمتد بامتداد ضلعه الجنوبية دكة عريضة (5) مساحتها 5 × 5 ، 4 يبدو انها كانت حجرة للأبواب، ثم دفنت في وقت آخر واستخدمت كدكة الشكل (7) .
تتصل هذه الدكة بدكة أخرى (6) في الضلع الشرقي تمتد بعرض (10، 1 متر)، تقسمها عرضيا ست وسائد على مسافة مترين بين الواحدة والأخرى مبنية باللبن وعليها لطوش من الجص.
ويصعد إلى هذه الدكاك بسلّمين صغيرين يتكون كل منهما من ثلاث مراق عرض الواحدة (75 سم) مبنية باللبن وعليها لطوش من الجص الخشن؛ لئلا تسبب التزحلق.
ص: 247
وتستند آخر وسادة على ظهر السلم المؤدي إلى السطح، والذي أزيل ولم يبق
الصورة

منه غير الدرجة الأخيرة.
وعلى الضلع الشمالية لهذا المجاز نجد بوابة أخرى، وهي من طراز البوابات المنعطفة التي عرفت من قبل في مدينة الحضر (1) ومدينة بغداد(2) وغيرها من المدن. فالدخول إلى الدار ليس مباشراً، وإنما من خلال هذه الباب، وربما الغرض من وجودها
ص: 248
بهذا الشكل يمنع سكان الدار من التعرض للخارج، إضافة إلى احتمال آخر هو تقليل دخول الأتربة والعواصف الرملية بشكل مباشر إلى داخل الدار، تتألف من جدارين مبنيين بالأجر والجص ، يستند كل منهما بواسطة التعشيق بالجدارين الملاصقين لهما كما في المدخل السابق، لم يبق من هذه البوابة الا أسس حيث تم نقل الطابوق إلى بنايات اخرى. وبين هذين الجدارين تمتد عتبة مبلطة بالطابوق الفرشي قياسه 28 × 28 × 9 ،
الصورة
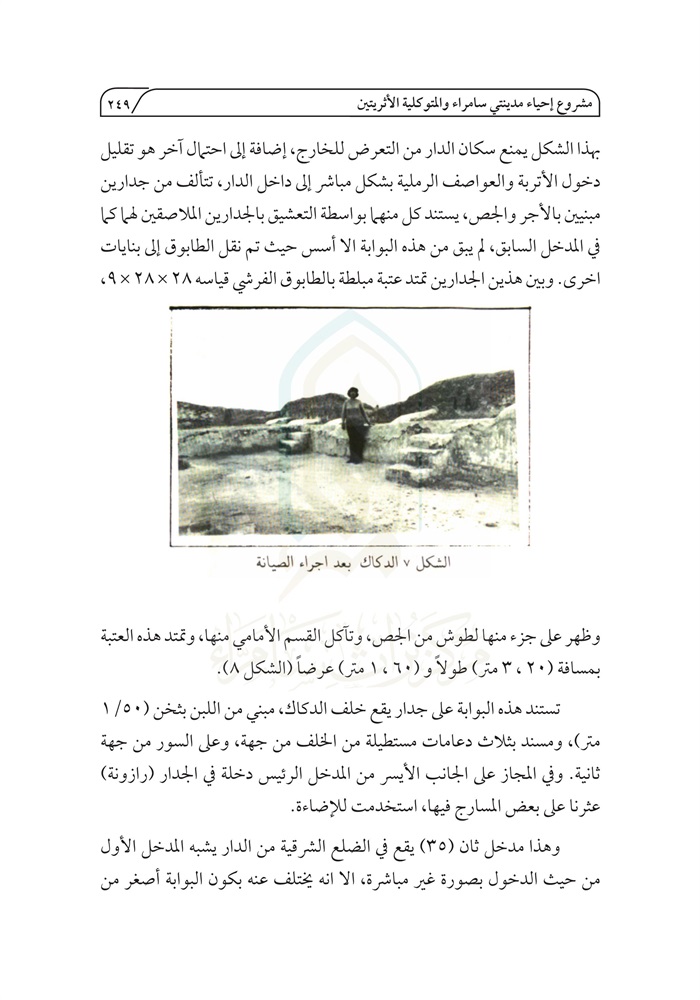
وظهر على جزء منها لطوش من الجص، وتآكل القسم الأمامي منها، وتمتد هذه العتبة بمسافة (20 ، 3 متر) طولاً و (60 ، 1) متر عرضاً (الشكل 8).
تستند هذه البوابة على جدار يقع خلف الدكاك، مبني من اللبن بثخن (1/50 متر)، ومسند بثلاث دعامات مستطيلة من الخلف من جهة، وعلى السور من جهة .ثانية. وفي المجاز على الجانب الأيسر من المدخل الرئيس دخلة في الجدار (رازونة) عثرنا على بعض المسارج فيها، استخدمت للإضاءة.
وهذا مدخل ثان (35) يقع في الضلع الشرقية من الدار يشبه المدخل الأول من حيث الدخول بصورة غير مباشرة ، الا انه يختلف عنه بكون البوابة أصغر من
ص: 249
الأول والمجاز كذلك، حيث يبلغ طوله (5 / 10) ، وعرضه (6 متر)، ويبدو خاليا من الدكاك التي وجدناها في المدخل الأول، وبجواره حجرة (36) مربعة لها مدخل واحد.
الصورة
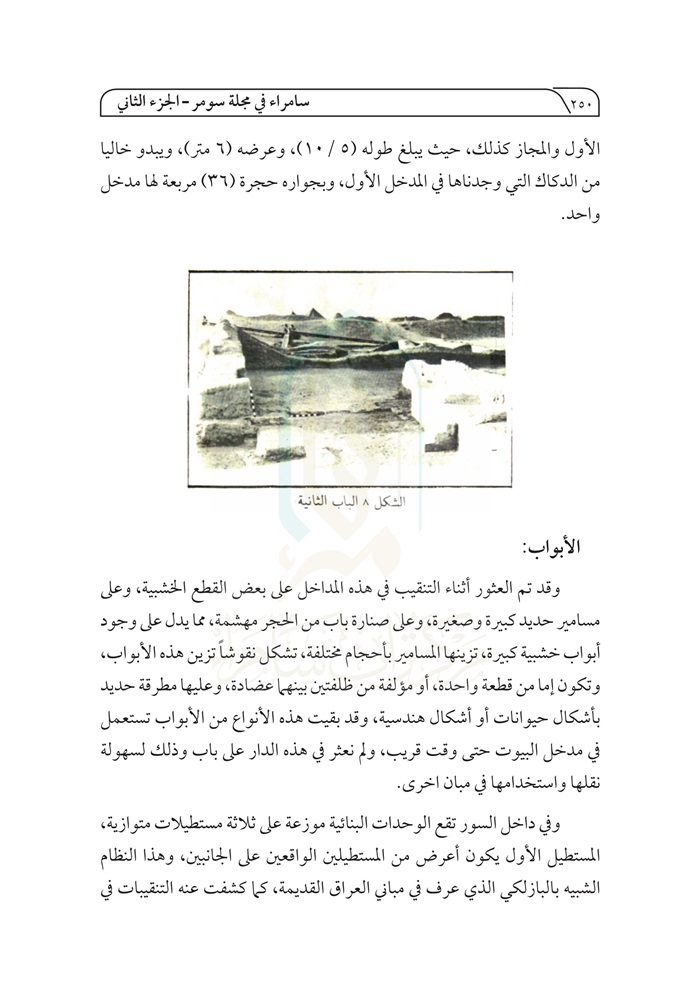
الأبواب :
وقد تم العثور أثناء التنقيب في هذه المداخل على بعض القطع الخشبية، وعلى مسامير حديد كبيرة وصغيرة، وعلى صنارة باب من الحجر مهشمة، مما يدل على وجود أبواب خشبية كبيرة، تزينها المسامير بأحجام مختلفة، تشكل نقوشاً تزين هذه الأبواب، وتكون إما من قطعة واحدة أو مؤلفة من ظلفتين بينهما عضادة، وعليها مطرقة حديد بأشكال حيوانات أو أشكال هندسية، وقد بقيت هذه الأنواع من الأبواب تستعمل في مدخل البيوت حتى وقت قريب ولم نعثر في هذه الدار على باب وذلك لسهولة نقلها واستخدامها في مبان اخرى.
وفي داخل السور تقع الوحدات البنائية موزعة على ثلاثة مستطيلات متوازية، المستطيل الأول يكون أعرض من المستطيلين الواقعين على الجانبين، وهذا النظام الشبيه بالبازلكي الذي عرف في مباني العراق القديمة، كما كشفت عنه التنقيبات في
ص: 250
كل من تل الصوان وتبة كورا وقاليج اغا، حيث يتميز بوجود المداخل الرئيسة فيه، والساحة المركزية والساحة الوسطى الكبيرة والممرات التي تؤدي إلى كافة الوحدات البنائية في المستطيلين الاخرين، والتي تحتوي على حجر للسكن ومخازن وحمامات، كما نجد مثل هذا التقسيم في دار الامارة في الكوفة (1).
ج- البيت الرئيس
وينفذ إلى القسم المركزي في الدار، وهو مقر صاحبه، ويستقبل فيه ضيوفه من خلال مدخل ثانوي (10) مباشر مستقل مكون من دهليز مستطيل، طوله خمسة أمتار، وعرضه متران، مبني باللبن والجص ، يخرج عن سمت الجدار من الأمام ببرج على كل جانب مربع ضلعه متر ونصف المتر، بينهما باب بعرض متر واحد (الشكل 9) وبتحضيرات من البرج نحو الداخل يتسع دهليز مستطيل ينتهي بمثل هذين البرجين، ومن ثخن الجدران 1،20 م وضخامة الأبراج يبدو ان سقفه كان مقبى، وكذلك من كثرة التراكمات والأنقاض والمقرنصات في الزوايا.
يؤدي هذا المدخل إلى ساحة كبيرة (20) مستطيلة الشكل أرضيتها رملية، وقد وجدنا في وسطها بئراً محفورة، وقد تركت المواد التي استخرجت من داخل البئر من حصى ورمال حول فوهته مما يدل على أن هذا العمل قد تم بعد ترك السكن في هذه الدار. تبلغ مساحة هذه الحديقة خمسة وخمسين متراً
الصورة
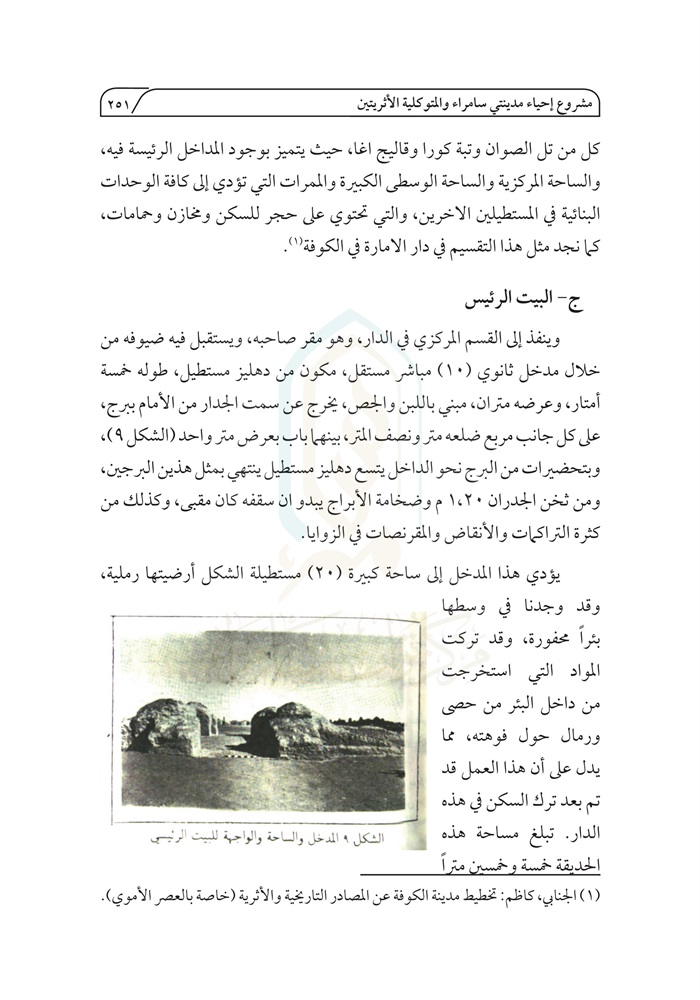
ص: 251
طولاً وثلاثة وثلاثين متراً ،عرضاً، قد قسمت إلى تسعة أمتار يليها مدخل طوله ثلاثة أمتار، إلى جانبيه دعامة بطول ثلاثة أمتار لثلاثة مداخل، ثم بقية ضلع الواجهة تسعة أمتار. وزينت المسافات التي بين المداخل بحنايا داخل الجدار، تتوجها من الأعلى عقود ثلاثية الفصوص، وبقيه الواجهة من القسم الشمالي وترك الضلع الجنوبية بدون زخرفة.
تؤدي هذه المداخل الثلاثة إلى مقدمة اولى مستطيلة الشكل، طولها ( 60 / 27 متراً) وعرضها (4/5 متر) ، حيث يقل طولها عن الواجهة بحوالي ثلاثة أمتار من كل جانب، ومن ثخن جدرانها وكثرة الأنقاض يبدو انها كانت مسقوفة بقبو (الشكل 10).
من هنا ينتقل الداخل إلى المقدمة (22) عبر ثلاثة مداخل مقابلة للمداخل السابقة، فيصبح أمام الإيوان الوسطي (25)، وهو القلب، ويسمى الصدر أيضاً، مفتوح من الأمام طوله عشرة أمتار ونصف، وعرضه ستة أمتار وعلى منكبيه الجناح الأيمن (26) والجناح الأيسر (27) حجرتان مربعتان ضلع كل منهما أربعة أمتار ونصف، وجميعها تطل على المقدمة بباب، وقد أضيفت له على جانبيه مرافق أخرى تتكون من ثلاثة حجر، الوسطى (28) بطول القلب، والحجرتان (31 ،23) بعرض المقدمة، يماثل هذا في الجانب الايسر، وخلف الإيوان تقع
الصورة
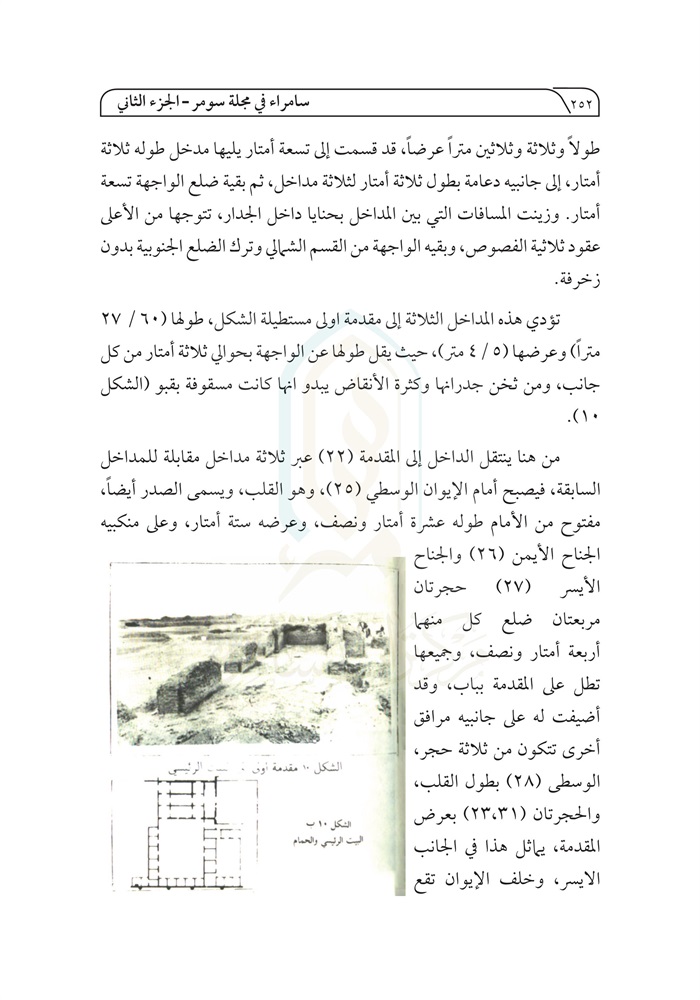
ص: 252
المؤخرة (30)، وتفتح عليه بباب واحد، وهذه ربما استخدمت كمخزن للشراب والمواد التي يحتاجونها في مجالس الأنس والطرب كما في قصر الأخيضر (1) ودار الإمارة في الكوفة (2)، وتفتح كل من حجرتي المؤخرة (23، 31) بباب على البستان (33) .
يشبه هذا الجزء الذي وصفناه بعض أقسام قصر رقم (4) الذي كشف عنه هر تزفيلد، والمحصور بين الساحة ج، الا انه هنا أكبر منه بإضافة مقدمة أولى إليه، ولهذا فهو يمثل الطراز الحيري الكامل الموسع، حيث أضيف إليه ثلاثة أقسام من كل جانب، وقسم من الأمام، وخصص هذا الجزء بأجمعه للاستقبال.
وقد اشتهرت سامراء في مبانيها باتباع هذا النظام وخاصة زمن الخليفة المتوكل ، حيث اعتبر من سمات عصره
وقد ذكر المؤرخ المسعودي عن الطراز الحيري (3) بان المتوكل اشتهر ببناء يسمى الحيري والكمين والأروقة بعد أن سمع من بعض سماره أن قسماً من ملوك الحيرة من النعمانية بنى مثل هذا البناء في مقر حكمه في الحيرة، وهي تمثل صورة الحرب، ويكون مجلس الملك في الرواق أو الصدر ، اما الكمان فعلى اليمين واليسار فهي لجلوس خواصه والى اليمين خزانة الكسوة والى الشمال مخزن الشراب، ويشمل الرواق الصدر والكمين والأبواب الثلاثة على الرواق (4).
ص: 253
يتصل هذا الجزء المهم من الدار ببقية الأقسام بواسطة تسعة أبواب ثلاثة في المقدمة، واثنان في المؤخرة، وبابان على كل جانب من الضلع الشمالية والجنوبية.
وعن طريق البابين في الضلع الشمالي يمكن الدخول إلى الدار المعدة لسكن العائلة والتي تحتوي على حجر للنوم وحمام كبير ومطبخ و مستراح موزعة حول صحن الدار (58) ، حيث تقع على ضلعه الشرقية خمس حجر (64 - 68) ، تميزت الحجرة (66) الوسطية بالسعة وباحتوائها على ثلاث دكاك، ربما خصصت لاستقبال الضيوف من النساء.
ولهذه الحجر مداخل تفتح على الصحن، وتميزت باتساعها، ويلاصقها حمام مؤلف من ثلاث حجر (69 - 71) سناتي على وصفه مفصلا ، كما يجاورها على الضلع الشمالية خمس حجر صغيرة (59 - 63) ، بالنسبة لحجر الضلع المجاور التي ذكرناها وقد استعملت الحجرة الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية (59) مستراحاً .
وعلى الضلع الغربية وجدنا خمس حجر 50 - 54 بأحجام 50 - 54 بأحجام مختلفة، حجرتان منها (52،53) تفتح باباهما على الصحن (58)، بجوارها مستراح (54) أصغر من البقية، وتحتوي على كوّتين ويفتح بابها على مجاز (55) ، يدخل إليه عن طريق باب من الممر (56) المنحدر باتجاه الشرق، عرضه متر ونصف والذي يؤدي إلى مجاز (57) وله باب يؤدي إلى الصحن (58).
ومن المجاز (55) يمكن الدخول إلى صحن (44) أصغر من الصحن السابق، وتفتح الحجرتان (50) - 51) بابيها عليه، وعلى الضلع الشمالية ثلاث حجر (47-49) أصغر من سابقتها.
وعلى الضلع الجنوبية مجاور المجاز (55) السابق ذكره حجرتان تميزت بمداخلها ذات الطلعات والدخلات وعضادة الجص ،حولها، مما يدل على استعمالها الخاص من قبل الضيوف؛ لقربها من المقدمة الأولى للدار (الشكل 11)، وربما تعتبر
ص: 254
ملحقاً بهذا الجزء.
وعند الانتقال من هذا الجزء من الدار إلى القسم الأمامي عليك أن تجتاز حديقة (43) واسعة ليس فيها أي اثر للتبليط، وأرضيتها رملية، مما يدفعنا للاعتقاد بانها كانت حديقة مزروعة ما عدا الضلع الجنوبية، ففيها آثار الجص القليلة المتبقية، مما يدل على وجود ممر مبلط ليسهل الوصول إلى البيت، واحتفظ القسم الأخير والذي يشكل ممراً عرضه متر ونصف باللطوش الجصية في القسم الأسفل منه.
الصورة
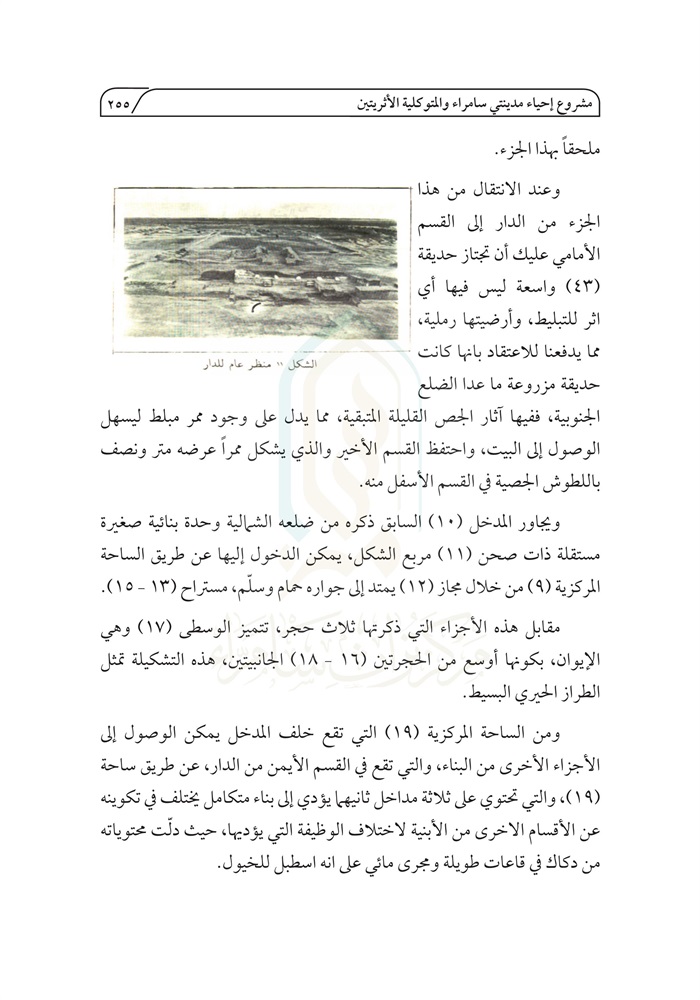
ويجاور المدخل (10) السابق ذكره من ضلعه الشمالية وحدة بنائية صغيرة مستقلة ذات صحن (11) مربع الشكل، يمكن الدخول إليها عن طريق الساحة المركزية (9) من خلال مجاز (12) يمتد إلى جواره حمام وسلّم، مستراح (13 - 15).
مقابل هذه الأجزاء التي ذكرتها ثلاث ،حجر، تتميز الوسطى (17) وهي الإيوان، بكونها أوسع من الحجرتين (16 - 18) الجانبيتين، هذه التشكيلة تمثل الطراز الحيري البسيط.
ومن الساحة المركزية (19) التي تقع خلف المدخل يمكن الوصول إلى الأجزاء الأخرى من البناء، والتي تقع في القسم الأيمن من الدار، عن طريق ساحة (19)، والتي تحتوي على ثلاثة مداخل ثانيهما يؤدي إلى بناء متكامل يختلف في تكوينه عن الأقسام الاخرى من الأبنية لاختلاف الوظيفة التي يؤديها، حيث دلّت محتوياته من دكاك في قاعات طويلة ومجرى مائي على انه اسطبل للخيول.
ص: 255
د الاسطبل
لهذا الاسطبل مدخلان، أحدهما من الساحة (19) المذكورة، والذي يؤدي إلى قاعة مستطيلة (72) تحتوي على دكاك وبئر ، وربما كان لها باب من الخارج على السور الجنوبي لدخول الخيل من فرع عرضه 30 / 13م المجاور لهذه الدار مباشرة، وفي ضلعها الغربية باب يفتح على صحن (73) يتوسط مجموعة أبنية لحجر ودكاك، فيه بالوعة في الوسط، ووجدنا بقايا تبليط الأرضية بالطابوق الفرشي قياس 28 × 28 × 9 (الشكل 12).
يقع على الضلع الشمالي للصحن حجرة (74) كبيرة قطع جزء منها واستخدم حماما، ويكون الدخول إليه من الحجرة (76) التي تميزت بوجود الدكاك فيها على امتداد ثلاثة أضلاع منها، وبوجود وسادة مبنية باللبن وعليها لطوش من الجص في الضلع الغربية منها، والى جانب المدخل من اليمين حوض يقابله من الجانب الثاني بقايا سلّم يؤدي إلى السطح (الشكل 23)، وتحت السلّم وفي الركن الشمالي الشرقي يقع المستراح (77).
كما تمتد على الضلع الغربية قاعة مستطيلة (78) على كل من ضلعيها الشمالية والجنوبية دكة مبنية بكتل من الحجر والطين ربما استخدمت لوضع العلف عليها الشكل (14)
الصورة

ص: 256
وعلى الضلع الشرقية توجد كوة في الجدار مغلفة بأجر رقيق قياسه 38 × 38 × 3، ومثله على جانبي المدخل لهذه القاعة. ويمتد على طول الضلع الغربية دكة بارتفاع متر واحد وعرض 50 سم، ترتفع حافتها الأمامية قليلاً، وعليها بقايا لطوش من الجص.
الصورة
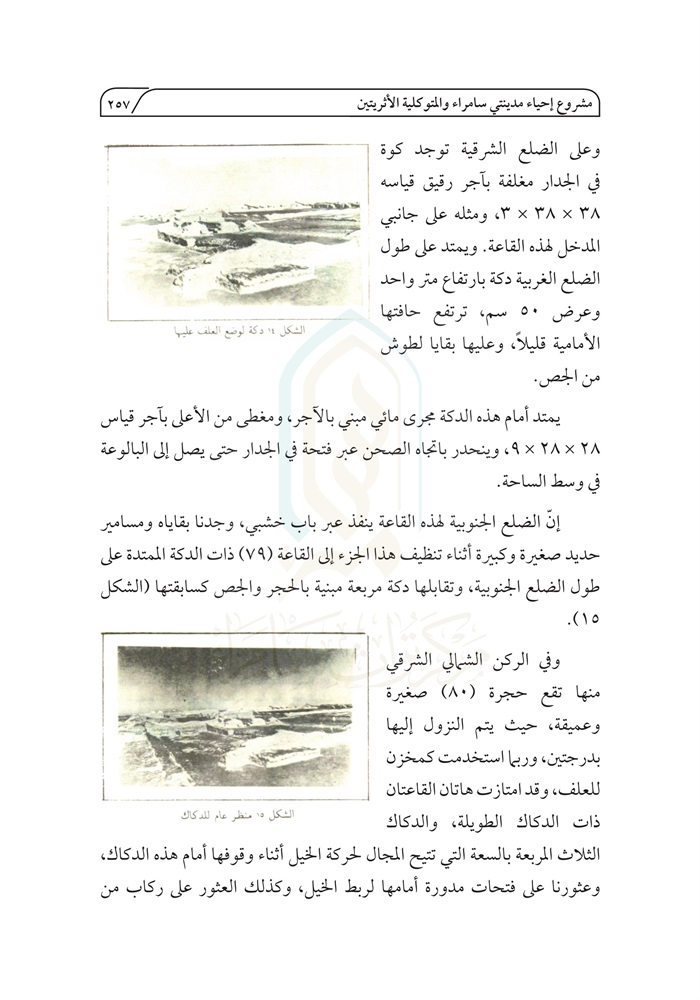
يمتد أمام هذه الدكة مجرى مائي مبني بالآجر، ومغطى من الأعلى بآجر قياس 28× 28× 9 ، وينحدر باتجاه الصحن عبر فتحة في الجدار حتى يصل إلى البالوعة في وسط الساحة .
إنّ الضلع الجنوبية لهذه القاعة ينفذ عبر باب خشبي، وجدنا بقاياه ومسامير حديد صغيرة وكبيرة أثناء تنظيف هذا الجزء إلى القاعة (79) ذات الدكة الممتدة على طول الضلع الجنوبية، وتقابلها دكة مربعة مبنية بالحجر والجص كسابقتها (الشكل 15).
وفي الركن الشمالي الشرقي منها تقع حجرة (80) صغيرة وعميقة، حيث يتم النزول إليها بدرجتين، وربما استخدمت كمخزن للعلف، وقد امتازت هاتان القاعتان ذات الدكاك الطويلة، والدكاك الثلاث المربعة بالسعة التي تتيح المجال لحركة الخيل أثناء وقوفها أمام هذه الدكاك، وعثورنا على فتحات مدورة أمامها لربط الخيل، وكذلك العثور على ركاب من
ص: 257
الحديد للخيل في أسفله جلد لا تزال بقاياه على الحديد كل ذلك جعلنا نطلق على هذا الجزء الاسطبل.
مرابط الخيل
ويتبع هذا الجزء وعلى وسط الضلع الشرقية منه تشكيلة بنائية أطلقنا عليها مرابط الخيل يمكن الدخول إليها من ممر (81) عن طريق بابين إلى صحن (82)، يحيط بست حجر (83 - 88) صغيرة الحجم 3 × 3م، تشترك بجدار في الوسط، وعلى كل جانب منه ثلاث حجر تفتح أبوابها باتجاه الشمال والثلاث الأخرى تفتح باتجاه الجنوب، ولم يبق من هذه الحجر سوى الأسس والأرضية المسيعة بالجص.
يدل تركيب هذا الجزء ووقوع الحجر بشكل يختلف عما ألفناه في الوحدات السكنية الاخرى، والتي تحيط بالساحة، بأنه مربط للخيل كل على حدة، ونستطيع ان نتوصل إلى عدد الخيل في هذه الدار ربما ستة خيول.
ه_- بيت سواس الخيل
يجاور الاسطبل والمرابط للخيل وحدة بنائية يبدو انها لسكن السواس، يتألف هذا البيت من صحن (89) مستطيل الشكل، يمتد على كل من ضلعيه الشرقية والغربية حجر غير متساوية المساحة، وتفتح جميع أبوابها باتجاه الصحن وتتميز إحدى هذه الحجر (96) بوجود دعامة من دعامات السور داخلها، كما سبق أن ذكرنا عند الكلام عن بناء السور أولاً . ثم إضافة البناء في الداخل. وقد احتوى هذا البيت والحمام 90 والمستراح 91 والمطبخ (101) والى جانبه موقد وبقايا سلم.
وبعد هذه الوحدة البنائية تمتد ساحة (102)، تنتهي عند نهاية البناء للقسم الوسطي من الدار، حيث وجدنا بقايا جدار ممتد يتصل بالسور، ويبدأ بعده البستان (33) الذي يكون الضلع الشرقي نهاية حدوده، ويشغل ثلث مساحة الدار تقريبا، ويبدو أنه كان مزروعاً، حيث لم نعثر على أي أثر للتبليط، وان تربته رملية، ويحتوي
ص: 258
على ثلاثة آبار للمياه، وفي وسطه حجرة (34) مبنية بالحجر ذات أربعة أبراج في الأركان ولها مدخل في كل من الضلع الغربية والجنوبية، وأمامها منخفض مملوء بالرمال، وربما كان موضعاً لنافورة أو حوض ماء أو بركة لتلطيف الجو الحار خاصة في فصل الصيف.
د- بيت الطيور
وفي نهاية البستان بيت للطيور يتألف من مجاز (103) يفضي إلى ساحة مستطيلة الشكل، على ضلعها الجنوبية حجرتان (105، 106)، وخلفها حجرتان صغيرتان (107 ، 108)، فيها أحواض وكوى صغيرة (أقنان) للطيور) ، ولكل منهما باب يفتح على البستان.
و - المطبخ
إن مدينة كسامرا احتوت على العناصر المهمة في البناء لم تهمل الجانب المهم في الحياة اليومية، وهو إعداد الطعام وطبخه، وكان يتم في أماكن مخصصة لهذا الغرض في أحد أركان البيت بعيداً عن التيارات الهوائية لمنع انتشار الدخان على ساكني الدار نظراً لاستخدام مواد أولية في عملية الاحتراق. وقد تم العثور في هذه الدار على عدة أماكن معدة للمطبخ ، وذلك لسعتها وتخصص كل قسم لسكن مجموعة، حيث وجدنا في كل وحدة سكنية حجرة تحتوي على موقد للنار فيه فحم ورماد وبقايا مواد وعظام محترقة، وكذلك على قناني زجاجية مهشمة وأطباق وأوان مكسورة جراء الاستعمال.
لقد أظهرت التنقيبات في هذه وجود مطبخ رئيس (38 - 42) يقع في الزاوية الشمالية الغربية يسار الداخل الشكل (16) ، يتصل بمجاز ذي أربعة أبواب الأولى يمكن الدخول فيها من الساحة المركزية (9) أمام المدخل الرئيس، وتقابلها أخرى تؤدي إلى صحن (39) على ضلعه الغربي قاعة (42) طويلة الشكل ذات مدخلين،
ص: 259
فيها أثار حروق على الأرض، ربما هي بقايا تنانير للخبز، وعثرنا أمامها على عظام ومواد متفحمة وعلى ضلعه الجنوبية حجرة مستطيلة (41) وجدنا فيها دكتين، الأولى على الضلع الشمالية مربعة الشكل مبنية بالحجر والطين، عليها لطوش من الجص تقابلها دكة اخرى مشابهة لها، وعلى أرضية الحجرة موقدان مبنيان بالطابوق. ووجدنا فيها كسراً من الأواني الفخارية والخزفية الكبيرة الحجم التي تستعمل للعجن والطبخ. وبقايا كسر أوان زجاجية كبيرة الحجم وعظام ورماد.
وإلى جانبها حجرة (140) ، وجدنا عليها بقايا ،قير ويبدو أنها كانت ملحقة بالمطبخ تغسل فيها الأواني.
والباب الثالثة من المجاز تؤدي إلى قاعة (38) مستطيلة الشكل ربما هي مخزن للمواد الغذائية التي يحتاجونها في الطبخ والخبز والمواد التابعة لها. والأواني الزجاجية والخزفية لعثورنا على أرضيتها على كسر من هذا المواد.
يظهر ان هذا الجزء مخصص لإعداد الخبز والطبخات الرئيسة لكافة سكان الدار.
وبالإضافة إلى هذا القسم وجدنا عدة مواقد، أما قرب المدخل الرئيس ذي الدكاك، فقد عثرنا على موقد مبني بالآجر وعليه اثار الحرق وبقايا الرماد وفي الأقسام التالية 14، 74 أ و 101 ، حيث وجدنا رماداً وحروقاً أيضاً. وبعض الكسر من المواد المستعملة للطبخ.
ولم نعثر على هذه المواد في أماكن اخرى من الدار.
أما الباب الرابع فتؤدي إلى الساحة 43 التي توصل إلى الدار الرئيسة من خلال بابين.
4 - المرافق الصحية
لقد توفرت في دور مدينة سامراء وسائل
الصورة

ص: 260
الراحة كافة لساكني هذه الدور ، وجميعها تدل على العناية بالنظافة ومراعاة الشروط الصحية، وشملت:
أ- الكنيف أو المستراح
لقد وجدنا في كل وحدة سكنية في هذه الدار مكانا خاصاً لقضاء الحاجة. وقد أطلق عليه عدة أسماء حسبما ورد في كتب التاريخ والأدب. وقد ذكر الحريري أن أهل الكوفة كانوا يسمونه الكنيف(1).
اما أهل العراق فقد أطلقوا عليه اسم المتوضأ أو المستراح (2).
وقد وجدنا موقعها في هذه الدار قريبة من الحمام أو تحت السلّم، ووجدنا فيها ظاهرة الكوة في الجدار في (54) إلى يسار الداخل، ويمينه كوتان لم نعرف سبب وجودها، وكذلك في (77) كوة (الشكل (17) إلى يسار الداخل قياسها 40 × 40 سم وعمقها 50 سم ، تبدو من الأعلى بشكل محدب وعليها لطوش من الجص ، نظيفة لم نلاحظ فيها ما يدل على استخدامها لوضع وسائل الاضاءة فيها. ولكن باطلاعنا على ما ورد في كتاب الغزولي (.... قام إلى المستراح وفي وسطه كيس فيه جملة من الذهب.... فحله وحطّه في كوة المستراح) وجدنا دليلاً يثبت ما ذكره المؤرخون حيث إن الآثار هي المادة التي تؤيد أقوالهم.
فهذه الكوة يوضع فيها ما يحمله الداخل إليها وخاصة الغرباء.
الصورة
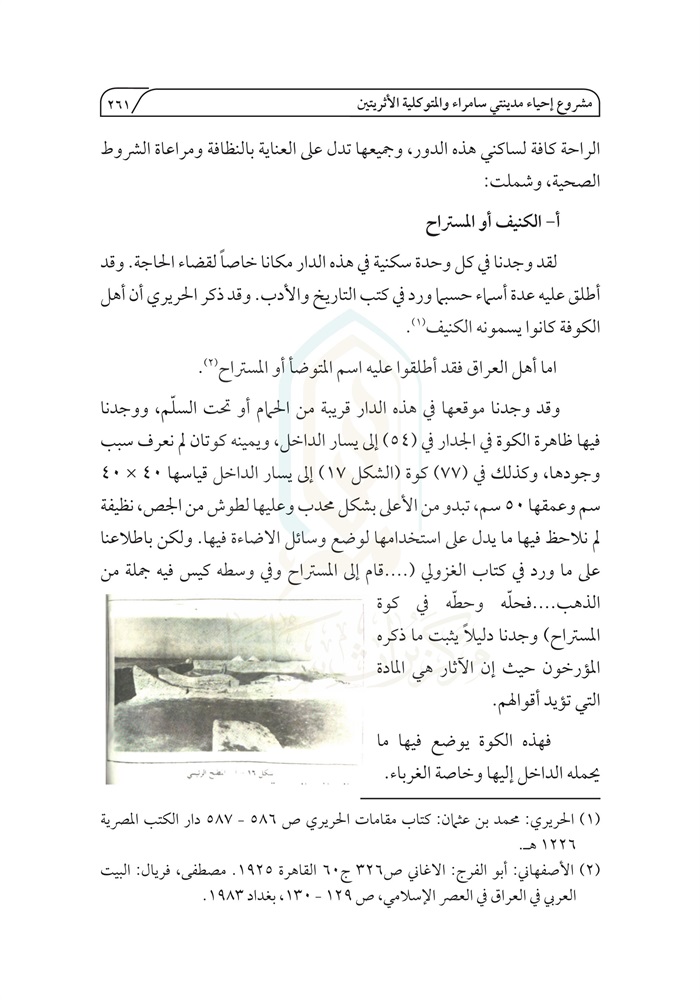
ص: 261
وهنا وجدنا اثنين فقط احتوتا على كوة، أما الباقية فلم نشاهد فيها مثل هذه الكوة وهي ،15، 59 ، 101 .
وتدل الآثار المتبقية منها على أن تركيبها ، بسيط، عبارة عن مسطبتين بينهما حفرة مستطيلة الشكل تتصل نهايتها بمجرى يؤدي إلى حفرة عميقة تسمى (التنورة) لجمع الفضلات فيها.
الصورة
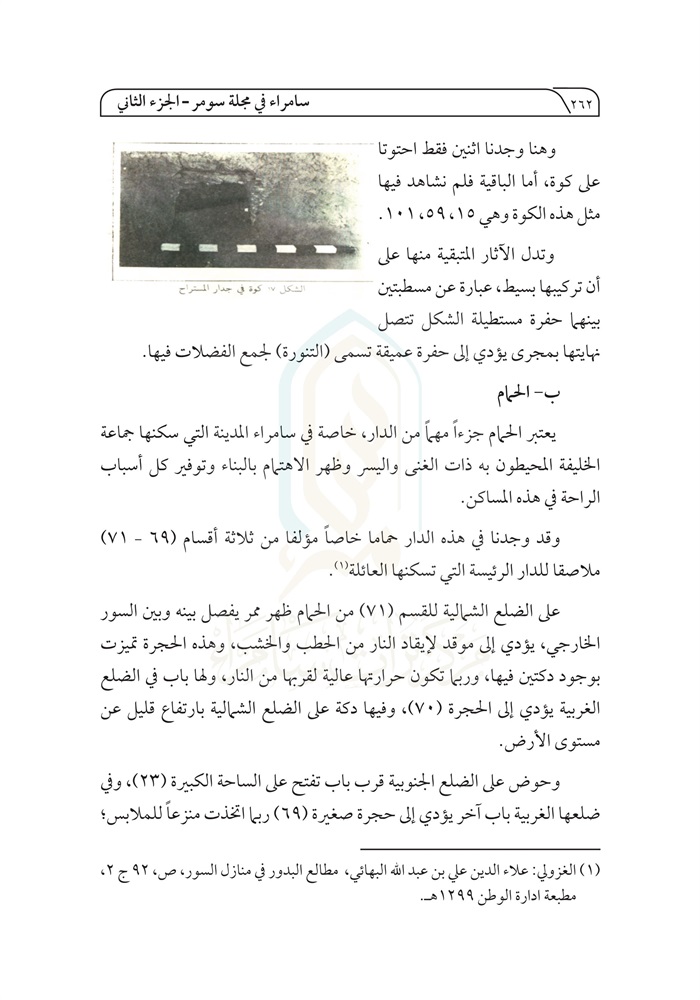
ب- الحمام
يعتبر الحمام جزءاً مهماً من الدار، خاصة في سامراء المدينة التي سكنها جماعة الخليفة المحيطون به ذات الغنى واليسر وظهر الاهتمام بالبناء وتوفير كل أسباب الراحة في هذه المساكن.
وقد وجدنا في هذه الدار حماما خاصاً مؤلفا من ثلاثة أقسام (69 - 71) ملاصقا للدار الرئيسة التي تسكنها العائلة(1).
على الضلع الشمالية للقسم (71) من الحمام ظهر ممر يفصل بينه وبين السور الخارجي، يؤدي إلى موقد لإيقاد النار من الحطب والخشب، وهذه الحجرة تميزت بوجود دكتين فيها، وربما تكون حرارتها عالية لقربها من النار، ولها باب في الضلع الغربية يؤدي إلى الحجرة (70) ، وفيها دكة على الضلع الشمالية بارتفاع قليل عن مستوى الأرض.
وحوض على الضلع الجنوبية قرب باب تفتح على الساحة الكبيرة (23)، وفي ضلعها الغربية باب آخر يؤدي إلى حجرة صغيرة (69) ربما اتخذت منزعاً للملابس
ص: 262
لوجود الدكاك فيها من جهاتها الثلاث لوضع الملابس عليها، والاستراحة بعد الاستحمام، وعدم تعرض المستحم إلى الهواء البارد مباشرة، وربما تفتح باب منها تؤدي اما إلى الحجرة (63) أو (68) لكي يرتبط الحمام بداخل الدار. ولكننا لم نجد هذا الباب للتخريب الحاصل على السور واتخاذه ممرا للعبور إلى الجهة الواقعة خلف الدار.
تميز هذا الجزء بانه كان مطلياً بالقير بارتفاع متر بالنسبة للجدران، كما تدل بقاياها وكذلك الأرضية المرصوفة بالحجر والمطلية بالقير وفيها حفر تدل على مجاري المياه، وان تصميم الحمام بهذا الشكل ليس حدثاً جديداً، بل وجد مثل هذا الحمام في قصر الأخيضر (1).
وبالإضافة إلى هذا الحمام الرئيس هنالك في الوحدات البنائية الأخرى التي يسكنها الخدم والقائمون على إدارة شؤون هذه الدار حمامات اخرى تتكون من حجرة واحدة صغيرة فيها دكة، وأرضيتها مطلية بالقير كما تدل بقاياها، ففي بيت الخدم في الحجرة (13) بقايا مواد من القير ، ويخرج منها مجرى مائي يصب في بالوعة في وسط الساحة .
وكذلك في الأقسام 50، 75 ، 90 فيها ما يدل على استعمالها حمامات.
5 - الميازيب
جمع ميزاب، وهو مجرى لتصريف مياه الأمطار عادة من السطح إلى الأرض ويفضل تصريف هذه المياه خارج الدار، وأبسط أنواعه ما كان مؤلفاً من فتحة في الجدار يتصل بها قطعة مستطيلة أو اسطوانية محدبة من صفيحة معدنية، ينزل عن طريقها الماء بعيداً عن الجدار.
ص: 263
أما ما عثرنا عليه في هذه الدار فيختلف عن هذا الشكل، حيث يتألف من حفرة في الجدار بعمق عشرة سنتمترات في القسم السفلي المتبقي منه، وتم الكشف عن ثلاثة ميازيب في الواجهة الأمامية وواحد في الضلع الجنوبية، وموقع هذه الميازيب في المناطق التي نجد فيها وحدات بنائية ذات سقوف، وقد لاحظنا بقايا في أسفل الجدران، وذلك لسقوط التراكمات عليها وتغطيتها وحفظها من التخريب على ارتفاع متر واحد وعليه لطوش من الجص واحتفظ بنظافته، ولم نشاهد عليه أي أثر المرور مياه الأمطار منه . مما يدعونا للاعتقاد بوجود خرطوم من صفيحة معدنية، تستقر في هذه الحفرة من الجدار يمر منها الماء (الشكل 18)؛ لأننا لم نلاحظ اي اثر التسرب المياه على الجدران المطلية بالجص المتبقية من هذه الميازيب. وربما نقلت هذه الميازيب المعدنية مع ما نقل من مواد لاستخدامها في مبان أخرى.
تذكر التقارير السابقة انه تم العثور على ميازيب معدنية في قصر الحويصلات (1)، وهذا يدفعنا للاعتقاد بوجود مثل هذه الميازيب في هذه الدار.
كما وجدنا بقايا ميزاب واحد في الجدار يصب داخل الدار على الجانب الخلفي للحجرة (68)، يصب في مجرى مائي من الحمام الرئيس .
6 - ظواهر عمارية
كشفت لنا هذه الدار ظواهر كثيرة جمعت كلها ضمن سور واحد وبناء متكامل، لم تكشف عنه الحفريات
الصورة

ص: 264
التي جرت في مدينة سامراء لحد الان، وهي:
1 - الدار مؤلفة من طابق واحد يمتد على مساحة واسعة كما دلت الأنقاض التي وجدت فيه.
2 - البناء محاط بسور ثخين عليه ابراج من الخارج، وله دعامات من الداخل، ومادته البنائية كتل من الجص في القسم الأسفل لارتفاع متر وبعده طوف من الطين بهيئة صفوف تسير على امتداده، ويبدو أنه قد شيد أولاً ثم أضيف إليه البناء في الداخل.
3- وجود مدخل رئيس في الضلع الغربية يشكل واجهة الدار من الخارج ويحتوي على الدكاك التي استخدمت للجلوس عليها أو النوم، وجود مداخل اخرى فيه وأرضيتها مبلطة بالطابوق.
4 - الجدران جميعها مطلية بلطوش من الجص من الداخل والخارج، ومادة البناء فيها هو اللبن.
-5 - أرضية الصحون الداخلية مبلطة بالطابوق الفرشي والذي لم يبق منه الا الأجزاء الواقعة قرب الجدران، والتي غطتها الأنقاض في وقت مبكر، فلم يخلع الطابوق عنها، وما عداها فقد خلع ونقل ولا تزال آثاره باقية على الجص الذي كان تحته، وبقياسات مختلفة هي طابوق فرشي قياس 24× 24 × 5، 24 × 24 × 25،7× 5× 6، 26× 26 × 5، 28 × 28 × 9 . ويقال: إنّ قياس الطابوق الأخير قد انتشر في زمن الخليفة المتوكل في جميع مبانيه.
6 - استخدام الدكاك في أجزاء كثيرة من هذه الدار والاستفادة منها.
7-وجود السلالم التي يصعد عليها إلى السطح للنوم صيفاً والسلالم التي تؤدي إلى الدكاك.
8- تحتوي هذه الدار على ثلاثين حجرة للسكن عدا القسم الخاص للضيوف
ص: 265
والمرافق الاخرى ، وحمام رئيس ومطبخ رئيس.
9 - احتوت على مخازن للمواد التي يحتاجونها.
10 - فيه اسطبل للحيوانات وبيت للطيور
11 - وجدنا خمس آبار موزعة فيه، ومجار لتصريف المياه وبلاليع لخزنها . كما وجدت عناصر استخدمت لزينة البيت الرئيس منها :
1 - وجود عضادات من الجص بشكل شريط يحيط بالأبواب من ثلاث جهات بارزة عن الجدار.
2- تغطية المدخل المحيط بالباب من الداخل بطابوق فرشی رقیق قیاس 3×31×31 .
- تزيين واجهة قاعة الاستقبال بحنيات بين الأبواب نحو الداخل تنتهي من الأعلى بطاقات صماء ذات عقود ثلاثية الفصوص شبيهة بالطاقات التي تزين جامع أبي دلف.
7- ميزات دار رقم (1)
بالإضافة إلى ما ظهر في هذه الدار من ظواهر عمارية قد نجد بعضها في دور سامراء. ولكننا لم نجدها مجتمعة كما وجدناها هنا برزت مميزات نستطيع ان نحللها ونستشف منها ما يلي: -
1- ثخن السور والجدران يعطي للدار هيبة ويمنع الصوت من الانتشار ويقلل الازعاج، أي يوفر لساكني الدار جواً هادئاً بعيداً عن المؤثرات الخارجية.
2- استعمال مواد الطين من لبن وطوف في البناء يحافظ على الموازنة في درجات الحرارة، والمحافظة عليها في الصيف وكذلك بالنسبة للشتاء.
ص: 266
3- المساحة الواسعة التي أمام الدار والمساحة المشغولة بالبناء والأجزاء المفتوحة بينها والتي تشكل الساحات والصحون والحدائق والتي تشغل 2 / 3 المساحة تدل على الرفاهية وسعة العيش والغنى.
4 - عدد الحجر في هذه الدار يعطينا فكرة عن عدد افراد العائلة.
5 - تقسيم هذه الدار إلى البيت الرئيس وتسكنه العائلة، وبيت للخدم، وبيت للسواس، يجعلنا نتصور إمكانية صاحب هذا البيت والنظام الطبقي، حيث يجند عدد كبير من الناس للقيام بخدمة عائلة واحدة.
8 - الآثار المنقولة
بالرغم من ان مدينة سامراء قد جرى الانتقال منها تدريجياً دون حدوث غزو أو حرب أو هجوم عليها، وتم نقل المواد التي يحتاجها سكان الدار في سكناهم الجديد. الا اننا وجدنا في هذه الدار وغيرها من الدور التي جرى التنقيب فيها آثار دلّت على المواد التي كانت تستعمل في سامراء، وسنصف ما عثرنا عليه في هذه الدار، فقد وجدنا مجموعة من كسر الفخار الساذج لأوانٍ كبيرة الحجم أو صغيرة الحجم وجرار بعض المقابض (شكل
الصورة

ص: 267
(19) وصحون صغيرة بعضها ذات حزوز ونقوش (الشكل 20) أو طبعات دائرية أو نقاط أو خطوط متقاطعة بعضها ذات طينة حمراء رقيقة جدا، أو ذات لون أصفر مائل إلى البياض.
وكذلك تم العثور على بعض الكسر من الخزف الأخضر بدرجات متفاوتة وكذلك الأزرق أو الأبيض أو ذات ألوان متعددة بشكل مخطط أو بقع (شكل 21). أو منقط أو منقوش تحت التزجيج، كما تم العثور على بعض الكسر الصغيرة من الخزف ذي البريق المعدني.
وتم التقاط بعض الكسر الزجاجية لصحون كبيرة الحجم أو قنان كبيرة وصحون وأوان متعددة الأشكال. بعضها رقيق جداً والآخر سميك ذات ألوان منها الأبيض أو الأخضر الفاتح أو الغامق المائل إلى السواد. وقد وجدنا بعض القطع أضيف إليها شريط زجاجي أشبه بالزخارف المضافة على الفخار المسماة الباريوتين.
وعثر على بعض القناني الزجاجية الكاملة (الشكل 22) وعلى بعض المقابض (شکل 23) والقواعد وكذلك الفوهات (شكل 24) الزجاجيات مهشمة .
الصورة

ص: 268
وتم العثور على مجموعة من المسامير الحديدية الكبيرة والصغيرة (الشكل 25) التي كانت تزين الأبواب الخشبية الكبيرة، وبعض القطع الخشبية (الشكل 26) وعلى ركاب حديد (الشكل 27) وكمية من الأصباغ بألوان مختلفة وعلى درهمين فضيين الشكلين28 ، 29 ، وسنصف ما عثرنا عليه:
عثرنا أثناء التنقيبات في هذه الدار على مسكوكتين فضيتين فوق أرضية الحجرتين (75 ،78)، وقد كانت إحداهما رقيقة جداً ومكسورة إلى ثلاث قطع، وقد تمت معالجتها في المختبر، وتبين من دراستهما أنهما درهمان يعودان إلى الدولة العباسية من زمن الخليفتين أبي جعفر المنصور (136- 158 ه_) (754 - 775م) ومحمد الأمين (193 - 198 ه_) (809 - 813 م).
لقد ضرب الخلفاء العباسيون الدراهم منذ سنة 132 ه_ ( 750 م) وهو تاريخ إعلان دولتهم على عهد الخليفة العباسي الأول عبد الله السفاح حتى سقوط الدولة العباسية على يد الطاغية المغولي سنة 656 ه_ (1258)م .
الصورة
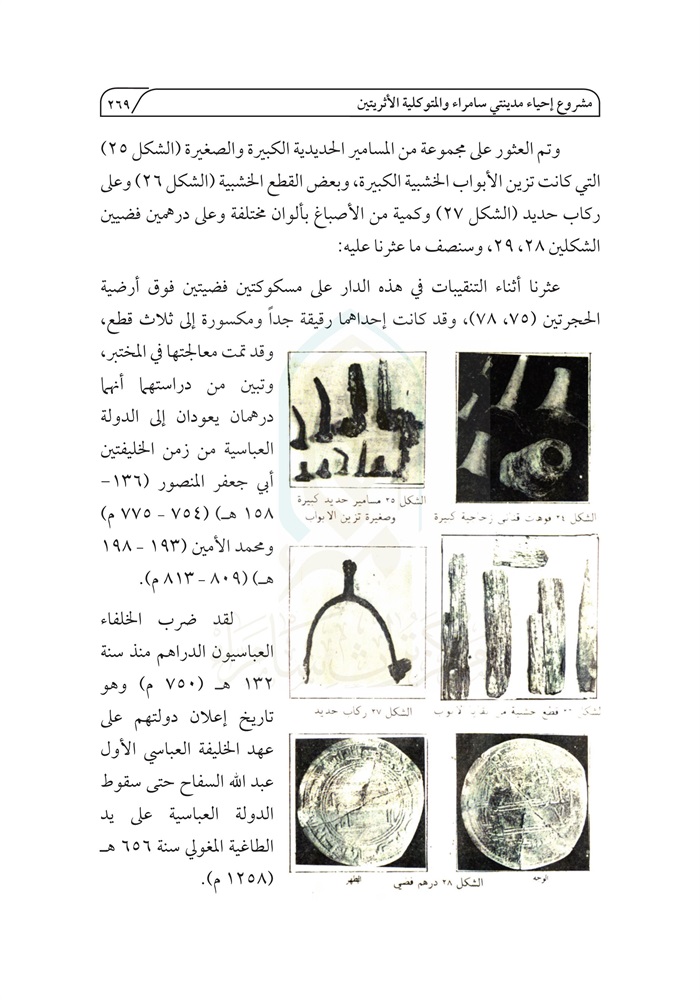
ص: 269
وقد أبدلت نصوص الظهر في الدراهم العباسية عما كانت عليه نصوص الدراهم الأموية، فقد نقشت عبارة (محمد رسول الله) بدلاً من سورة التوحيد:
1 - مسكوكة فضية للخليفة أبي جعفر المنصور مؤسس مدينة بغداد (شكل 28)
الوزن: 50 / 2 غرام
القطر : 25 م
المعثر: فوق أرضية حجرة رقم 75
كتب عليها: ضرب المحمدية سنة 137ه_
الوجه ... الظهر
لا اله الا ... محمد
الله وحده ... رسول
لا شريك له ... الله ك
بسم الله ضرب هذا محمد رسول الله أرسله بالهدى
الدرهم بالمحمدية سنة ودين الحق ليظهره على الدين
سبع وثلاثين ومية كله ولو كره المشركون
أما المحمدية فقد ورد اسم هذه المدينة على السكة العباسية، وهناك ست مدن:
-أ- المحمدية : مدينة بكرمان
ب- المحمدية : مدينة بنواحي الزاب من أرض المغرب
ج - المحمدية : مدينة من أعمال برقة من ناحية الاسكندرية
ص: 270
د- المحمدية : مدينة ببغداد من قرى بين النهرين
ه_ - المحمدية : قرية من نواحي بغداد
و - المحمدية: قرية المسيلة بالمغرب
2- مسكوكة فضية للخليفة محمد الامين ابن الخليفة هارون الرشيد (الشكل 29) الوزن: 2/80 غرام.
القطر : 22 م م
المعثر: فوق أرضية الحجرة 78.
كتبت عليها ضرب مدينة المحمدية سنة 193 ه_ .
الصورة
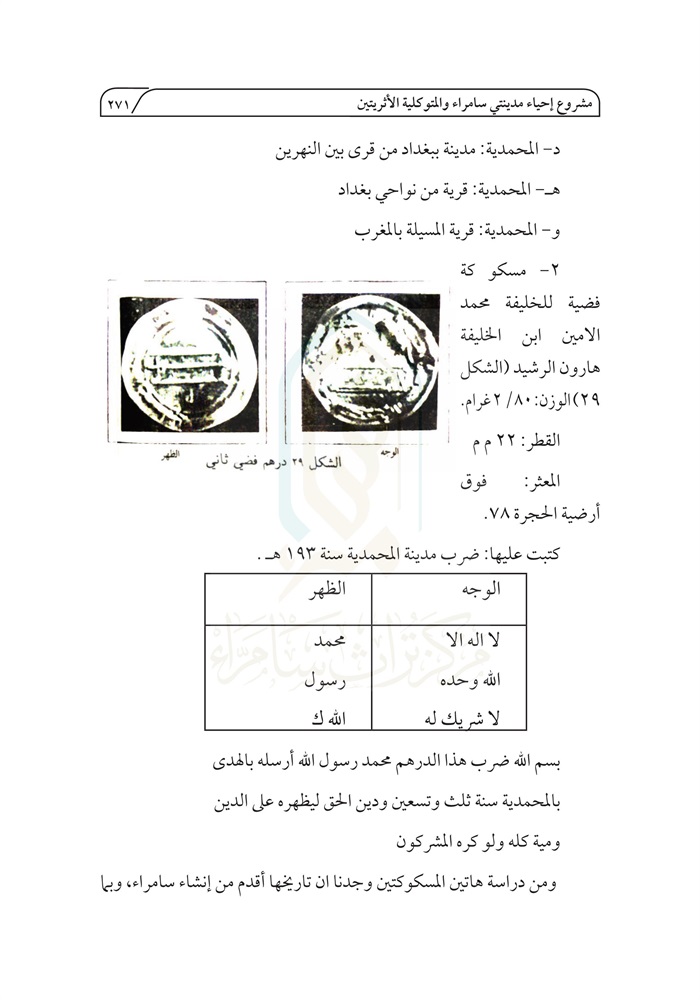
الوجه ... الظهر
لا اله الا ... محمد
الله وحده ... رسول
لا شريك له ... الله ك
بسم الله ضرب هذا الدرهم محمد رسول الله أرسله بالهدى
بالمحمدية سنة ثلث وتسعين ودين الحق ليظهره على الدين
ومية كله ولو كره المشركون
ومن دراسة هاتين المسكوكتين وجدنا ان تاريخها أقدم من إنشاء سامراء، وبما
ص: 271
انهما من الفضة فقد احتفظ بهما ونقلا إلى سامراء (1).
الأصباغ
تم العثور على كمية من الأصباغ ذات ألوان مختلفة في حجرة 74 أ مجاورة للاسطبل وبجانبها موقد عليه أصباغ ذائبة، ويتصل بساقية وجدنا بقايا أصباغ فيها، وتتميز كتل الأصباغ التي وجدناها بثقلها وخاصة اللون البرتقالي، أما اللون الأحمر فأقل ثقلاً. ووجدنا اللون الأزرق يشبه مادة (الجويت) التي تستعمل في غسل الملابس تتميز هذه الصبغة بكونها طباشيرية، وقد تم إرسال هذه العينات من الأصباغ إلى مختبر المؤسسة العامة للآثار والتراث، وقامت السيدة باهرة القيسي بتحليله، وكانت النتيجة ما يلي:
1 - الصبغة الحمراء
تتكون هذه الصبغة من المواد التالية:
أ- اوكسيد الحديديك red ochre fe2O3
او hydrated ironoxlde Fe2O3 NH2O
ب- red mercurle sulphlde Vermilion HgS
2 - الصبغة البرتقالية
تتكون من :
أ- اوكسيد الرصاص pbO, litharge
ب- شوائب من التراب الأصفر والبرتقالي Ocre Jaune
3 - الصبغة الزرقاء Fe2O3H2O.
ص: 272
تتكون من:
أ- Azurlte وهي طبيعة عبارة عن كاربونات النحاس القاعدية 2CuCO3Cu(OH)2
ب - Smalt سليكات البوتاسيوم (زجاج) وألمنيوم، وتكون زرقاء من أوكسيد الكوبالت KCO(AL)2 Silicate glass)
إن عثورنا على الأصباغ والموقد قرب الاسطبل دفعنا للاعتقاد بان هناك علاقة بينها وبين الخيول، فربما استخدمت هذه الأصباغ في وضع علامة مميزة للخيول التي تعود لصاحب هذه الدار عن الخيول الأخرى التي تعود للدور المجاورة، او استخدمت للمعالجة لبعض الأمراض التي تصيب الخيل.
وتم العثور على جرار من الفخار كاملة بأحجام مختلفة وقليلة العدد الا انها تعطي الشكل العام السائد استعماله في هذه الفترة وكذلك على مسارج وبعض القناني الزجاجية الصغيرة التي ظلت في أماكنها .
وسنتعرض لما وجدناه كاملاً بالوصف كلاً على حدة.
1- جرة من الفخار (الشكل 30) كمثرية الشكل طينتها صفراء ذات بدن كروي ورقبة طويلة وفوهة واسعة لها مقبض واحد عليه نتوء من الأعلى، قاعدتها دائرية ذات بروز نحو الخارج.
في أعلى البدن نقش محزز يتألف من خطين متوازيين بينهما دوائر
المعثر : المدخل الرئيس (4)
القياسات: الارتفاع 24 سم، قطر الفوهة 5 / 6 سم.
الصورة
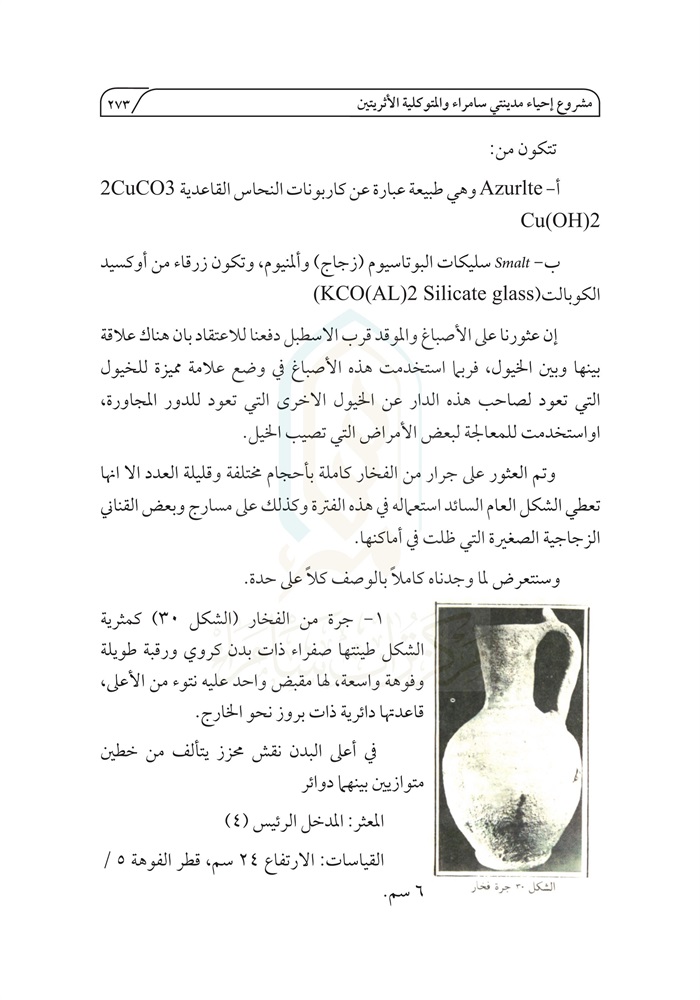
ص: 273
عنق الفوهة 8 سم . محيط البدن 45 سم
2- جرة من الفخار طينتها صفراء مائلة إلى البياض ذات بدن مضلع وفوهة واسعة مكسورة، وقاعدة مستقيمة تميل نحو الخارج قليلاً، عليها بقايا مقبض واحد مكسور.
یزین البدن خطوط مستقيمة (الشكل 31) قياساتها
ارتفاع 5 / 10سم، قطر البدن 5 / 36 سم، قطر الفوهة 5 / 6سم.
المعثر حجرة 90 .
مسرجة
وجدنا بعض المشاعل كانت في طاقة صماء قرب
المدخل وسقطت على الأرض، وهذه بشكل مشعلة (نفطية ) كروية البدن ذات فوهة ضيقة مكسورة، وعليها اثار الحرق وقاعدتها مستوية (الشكل 32).
الصورة

القياسات
الطول 11 سم قطر البدن 30سم
المعثر في المدخل (4) الرئيس.
4 - قنينة زجاجية صغيرة رقيقة جداً ذات رقبة مكسورة قاعدتها مضغوطة بأصبع الإبهام أثناء النفخ (الشكل 40 ) .
القياسات: الطول 5 / 2 سم ، قطر البدن 5 / 10سم
ص: 274
المعثر حجرة 84 .
5- قنينة زجاجية صغيرة ذات لون أخضر وبدن كروي ورقبة طويلة، ولها قاعدة مضغوطة كالقنينة السابقة (الشكل 40 ) .
الطول : 5 - 4 سم الفوهة 2 / 2 . قطر الفوهة 2 / 1 سم
القاعدة 3سم
المعثر في المدخل الثاني (35).
6 - قنينة زجاجية صغيرة ذات بدن مضلع الشكل رباعي ورقبته خماسية الأضلاع، على البدن زخارف بارزة تمثل مراوح نخيلية غالباً واستخدمت لوضع العطور فيها (الشكل 22).
القياسات: الطول 2 / 6 سم الرقبة 5 / 2 سم قطر الفوهة 4 / 1سم
المعثر حجرة 106 .
7 - إناء من الخزف صغير الحجم مكسور جزء منه مزجج من الداخل والخارج بلون أخضر فاتح له قاعدة قليلة الارتفاع (الشكل 33)
القياسات: ارتفاعه 2 / 4 سم قطره 3 / 9 سم
قطر القاعدة 5 سم ارتفاع القاعدة 1 سم
المعثر حجرة 69 .
الصورة
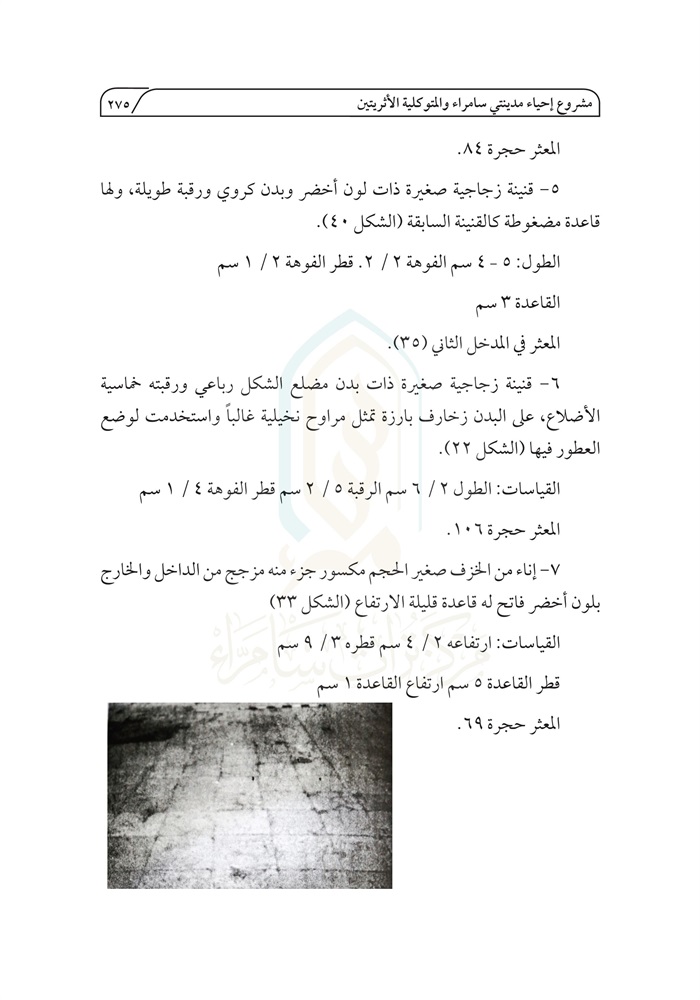
ص: 275
الصورة
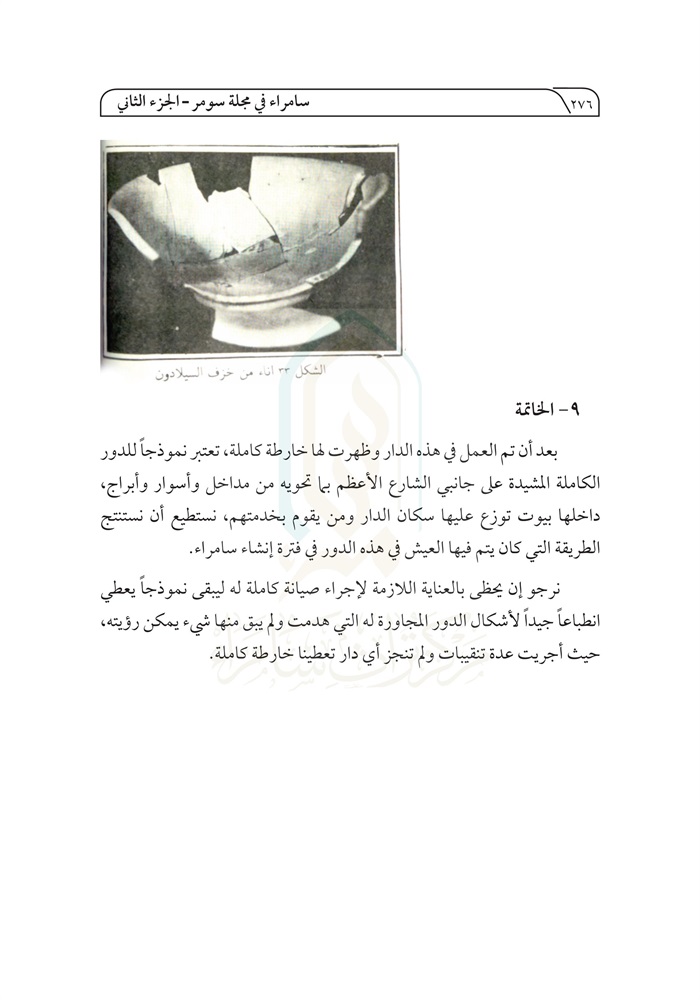
9 - الخاتمة
سامراء في مجلة سومر - الجزء الثاني
بعد أن تم العمل في هذه الدار وظهرت لها خارطة كاملة، تعتبر نموذجاً للدور الكاملة المشيدة على جانبي الشارع الأعظم بما تحويه من مداخل وأسوار وأبراج، داخلها بيوت توزع عليها سكان الدار ومن يقوم بخدمتهم، نستطيع أن نستنتج الطريقة التي كان يتم فيها العيش في هذه الدور في فترة إنشاء سامراء.
نرجو إن يحظى بالعناية اللازمة لإجراء صيانة كاملة له ليبقى نموذجاً يعطي انطباعاً جيداً لأشكال الدور المجاورة له التي هدمت ولم يبق منها شيء يمكن رؤيته، حيث أجريت عدة تنقيبات ولم تنجز أي دار تعطينا خارطة كاملة.
ص: 276
مصادر البحث:
1 - أبو الصوف بهنام التنقيب في تل الصوان، الموسم الرابع، مجلة سومر، مجلد 4 ، بغداد و 1968 ، التنقيب في تل الصوان الموسم الخامس، مجلة سومر، مجلد 27، بغداد 1971.
2- الاصطخري ابن إسحق إبراهيم بن محمد: المسالك والممالك القاهرة 1381 ه_ / 1961م.
3- الأصفهاني، أبو الفرج، الاغاني القاهرة 1935م.
4 – الجنابي، كاظم إبراهيم، تخطيط مدينة الكوفة عن المصادر التاريخية والأثرية (وخاصة في العصر الأموي)، بغداد 1967م.
5- الحريري، أبو القاسم محمد بن عثمان، مقامات الحريري، دار الكتب المصرية 1326 ه_.
6- السامرائي، يونس الشيخ إبراهيم، تاريخ مدينة سامراء، جزآن المجمع العلمي العراقي 1968م.
7- سفر، فؤاد: واسط الموسم السادس للتنقيب، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة 1952م.
8- سفر، فؤاد ،مصطفى، محمد علي: الحضر مدينة الشمس بغداد 1974 م.
9 – سوسة، احمد: ري سامراء في عهد الخلافة العباسية، جزآن، بغداد 1948م.
10 – العميد، طاهر مظفر: بغداد مدينة المنصور المدورة، بغداد 1987 ه_ 1967م.
11 - الغزولي: علاء الدين علي بن عبد الله البهائي، مطابع البدور في منازل
ص: 277
الشرور. مطبعة ادارة الوطن 1299 ه_.
12 – القزاز: وداد علي، الدرهم العباسي. مجلة سومر مجلد 43 بغداد 1967.
13 - القزويني: زكريا بن محمد بن محمود آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت 1380 ه_ 1960 م.
14 - متز، آدم الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. جزآن.
15- مرزوق: محمد عبد العزيز، العراق مهد الفن الإسلامي، بغداد المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ت 346 ه_، مروج الذهب ومعادن الجوهر، بيروت 1385 ه_ - 1966م.
16 - مهدي علي محمد، الأخيضر ، بغداد 1969م.
17 - ياقوت شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت عبد الله الحموي الرومي البغدادي ت 626 ه_، معجم البلدان.
18 - اليعقوبي : أحمد ابن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح، ت 284 ه_ البلدان ، ضمن الاعلاق النفيسة، طبعة ليدن 1891
19 - مديرية الآثار العامة: حفريات سامراء 1936 - 1939، ج 1 - 2، بغداد 1940.
20 - تقارير مديرية الآثار القديمة : التنقيب في الحويصلات لسنة 1936 – 1939.
ص: 278
المجلد الثالث والأربعون سنة 1984.
- من سامراء -
باهرة عبد الستار أحمد القيسي
أجري التحليل مجهريا لهذه الصبغات بأخذ عينات بقدر رأس الدبوس ووضعها على شريحة زجاجية ومن فحص البلورات بمختلف أشكالها وألوانها يتعرف المحلّل على نوع الصبغة بشكل مبدئي. ومنه يتعرف على نوع المكاشف لهذه الصبغات، وبهذا يقرر المحلل الصبغة المستخدمة، وذلك بالرجوع إلى جداول خاصة بالصبغات.
المثال الأول:
صبغة وردية محمرة: تحت المجهر ظهرت بشكل بلورات ناعمة قسم منها ينقصها الشكل البلوري. وبإضافة حامض الهيدروكلوريك المركز الثابت ذابت معظم الصبغة وقليل من الراسب الأبيض الذي هو كلوريد الرصاص. وعند إضافة حامض النتريك المركز حصلنا على راسب بني هو ثاني اوكسيد الرصاص. وقد أعطت الصبغة كشف الموجب للحديد والرصاص. ومن هذا نستدل على أن الصبغة هي متكونة من
( أ ) أوكسيد الحديد المعروف بالرمز haematite Fe2O3
(ب) الرصاص الأحمر أي رابع أوكسيد الرصاص pb304.
(Read Lead) المسماة Minium of Lead
المثال الثاني:
ص: 279
الصبغة خضراء اللون: تحت المجهر ظهرت بشكل بلوري، ولونها ازرق مخضر باهت، وبإضافة الحامض تخرج فقاعات لثاني اوكسيد الكاربون نتيجة وجود الكاربونات الخاصة بالنحاس. والصبغة أعطت كشفاً موجباً للنحاس بكثرة وبصورة أقل كشفاً موجباً للكروم، اي ان الصبغة تتكون من ( آ ) كاربونات النحاس القاعدية (المالاكايت) صبغة طبيعية من الجبال.
Malachite CuCO3. Cu(OH)2
(ب) اوكسيد الكروم 2H2O 03 Chromium Oxide Cr2
المثال الثالث :
الصبغة زرقاء اللون تحت المجهر لماعة خضراء مزرقة بلورية غير منتظمة بالشكل والحجم، أعطت كشفاً موجباً للنحاس، وبصورة أقل للحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والالمنيوم، ومن ذلك يتضح ان الصبغة متكونة من ( أ ) أزورايت - صبغة طبيعية من الجبال 2(Azurite 2CuCo3.Cu(OH (ب) السيليكات، وهي طبيعية وتسمى (Mayen Blue)، وهي سيليكات لكل من الالمنيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، ووجدت بعض الشوائب من الكالسيت (كاربونات الكالسيوم).
المثال الرابع:
( أ ) الصبغة سوداء اللون تحت المجهر اللون بني غامق وتذوب في المحاليل العضوية، وقد أعطت كشفاً موجباً للحديد فاتضح أن الصبغة من القير (Bitumen) .
(ب) الصبغة البيضاء: تحت المجهر مسحوق ناعم وبشكل بلوي. وبإضافة حامض خرجت فقاعات ثاني اوكسيد الكاربون لوجود الكاربونات، وأعطت الصبغة كشفاً موجباً للكالسيوم، وبهذا فالصبغة تتكون من نسبة كبيرة من الجبس
ص: 280
CaSO4
Calcium sulphate anhydrite
ونسبة قليلة من المادة الطباشيرية (Whiting Chalk) CaCO3
المثال الخامس:
(أ) اللون أسود مزرق مثل النموذج الثالث از ورایت Azurite) وشوائب من التربة أعطت كشفاً موجباً للحديد وسيليكا.
(ب) اللون أصفر : تحت المجهر دقائق صغيرة جداً ذهبية بالضوء المنعكس، وهي بلورات منتظمة وتذوب في حامض الهيدروكلوريك بقلة، وقد أعطت كشفاً موجباً للحديد أي صبغة طبيعية المسماة (الاوكر الأصفر) Yellow care وشوائب من السيليكا والطين.
ص: 281
ص: 282
المجلد الرابع والأربعون سنة 1986
قاسم راضي حنين
منقب آثار
إذا كان لم يصلنا من آثار مدينة المنصور «بغداد» ما يمكن الاستدلال به على ما أورده الخطيب البغدادي.. فإن مدينة المعتصم (سامراء» قد قاومت عاديات الزمن واحتفظت بمعظم عناصرها العمارية والزخرفية أحد عشر قرناً، وفي حالة يمكن معها الاستدلال على نظام تخطيط شوارعها ومبانيها بشكل كامل، فهي والحالة هذه تعتبر أقدم المدن العباسية الباقية، وأعظمها شأناً وقيمة أثرية. وكذلك أكثرها فسحةً واتساعاً، ويتضح ذلك بجلاء من الصور الجوية التي توضح الكثير من أجزاء المدينة المترامية الأطراف، إذ امتد العمران فيها على مسافة تقرب من 34 كيلو متراً، ووصل عرضها على ضفتي نهر دجلة (5-3) كيلو مترا، وقد تم ذلك كله في فترة قصيرة من الزمن، حوالي نصف قرن.
وعلى الرغم من قصر هذه الفترة التي عمرت فيها هذه المدينة فإن عمرانها أحدث تطورا غير مألوف في تاريخ العمارة والفنون الإسلامية، كما أوضحتها التنقيبات التي كشفت جوانب مهمة من القصور والدور والتي نقبت على أيدي الأجانب مثل هنري فوليه و هر ترفيلد وسارة، وذلك للسنوات (1908 - 1913)، وكذلك التنقيبات التي أجريت على أيدي الرواد الأوائل من المنقبين العراقيين(1) منذ
ص: 283
سنة 1936 ، ولفترات موسمية متقطعة وحتى عام ،1981 ، عندما ظهر إلى الوجود مشروع تطوير مدينتي سامراء والمتوكلية، وبدأت بذلك الأعمال الواسعة في مجالي التنقيب والصيانة لمدينة سامراء ومن ضمنها دار رقم 4 في منطقة مدق الطبل، والتي سنتناول دراستها بشكل مفصل على الصفحات المقبلة.
القسم الأول: -
أعمال التنقيب: -
تقع هذه الدار إلى الجنوب من قصر الخليفة «الجوسق الخاقاني» في سامراء، وعلى بعد 450 متراً إلى جانب الساحة الكبيرة المعروفة اليوم باسم مدق الطبل «مخطط (1، 2)»، وتعرف عند المشتغلين بالآثار باسم دار رقم 4 ، كانت قد وقفت تنقيبات الأعوام 36- 1939م في كشف الجزء الأكبر منها وخلال أربعة مواسم، 36-939 نشرت نتائج التنقيب فيها عام 1940م، ضمن أعمال التنقيبات التي جرت في مدينة سامراء حينذاك (1).
ولقد استكمل التنقيب فيها أواخر عام 1981 وبداية عام 1982، ورفعت الأتربة والأنقاض من أغلب غرفها وساحاتها، حيث ظهرت التباليط الأصلية لها وبذلك تم التوصل إلى معرفة التصاميم التفصيلية لبناء الأجزاء الداخلية لهذه الدار التي تشغل مساحة مستطيلة من الأرض قياسها 122 متراً طولاً من الشمال إلى الجنوب و 62 متراً عرضاً من الشرق إلى الغرب، فتكون مساحتها العامة 7564 متراً مربعاً.
ص: 284
الصورة

ص: 285
الصورة
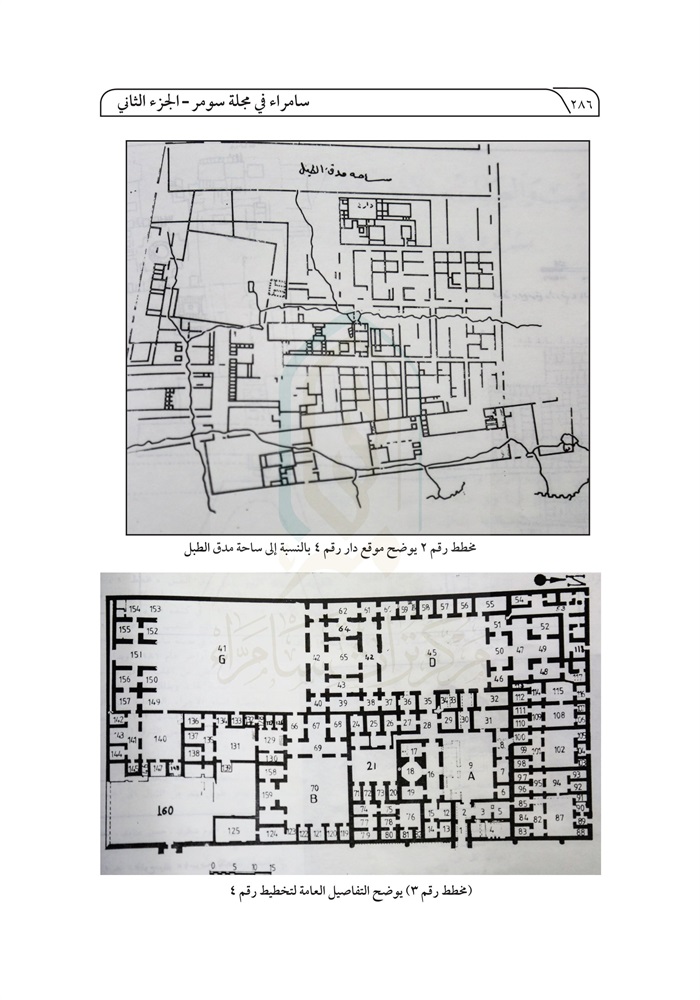
ص: 286
والتفاصيل العامة لتخطيطها تكاد تنحصر ضمن قسمين رئيسين، يفصل بينهما جدار طويل يمتد من الشمال إلى الجنوب تتخلله مجموعة من الأبواب، توصل إلى القسمين الشرقي والغربي بساحاتهما المكشوفة وغرفهما المئة والخمسين الموزعة على تلك المساحات «مخطط 3».
ومن الملاحظ ان القسم الغربي فيها يشبه من حيث التخطيط ومواد البناء والمساحة دار رقم 2 «مخطط 4» القريبة منها ، والمكشوف عنها في تنقيبات عام 1936 -1937، والفروقات بينهما ضئيلة جداً لدرجة لا تثير أي انتباه.
وعلى امتداد محور الأيوان (151) وباتجاه الشمال وحتى الإيوان (49) لنا ان جهتي يتوضح هذا القسم «اليسرى واليمنى» تمتازان بخاصية التناظر والتشابه التام في التخطيط والمساحة، حيث يشكل الإيوان (65) مركزاً وسطياً أو بالأحرى إيواناً مزدوج الرواق يتصل من جهة الشمال بسقيفة مستعرضة (رواق) تطل على الساحة المكشوفة (45) ببائكة ثلاثية أوسعها الفتحة الوسطى، كما يتصل كذلك من جهة الجنوب بسقيفة مستعرضة تطل على الساحة المكشوفة ( 41 ج-) ببائكة خماسية.
الصورة
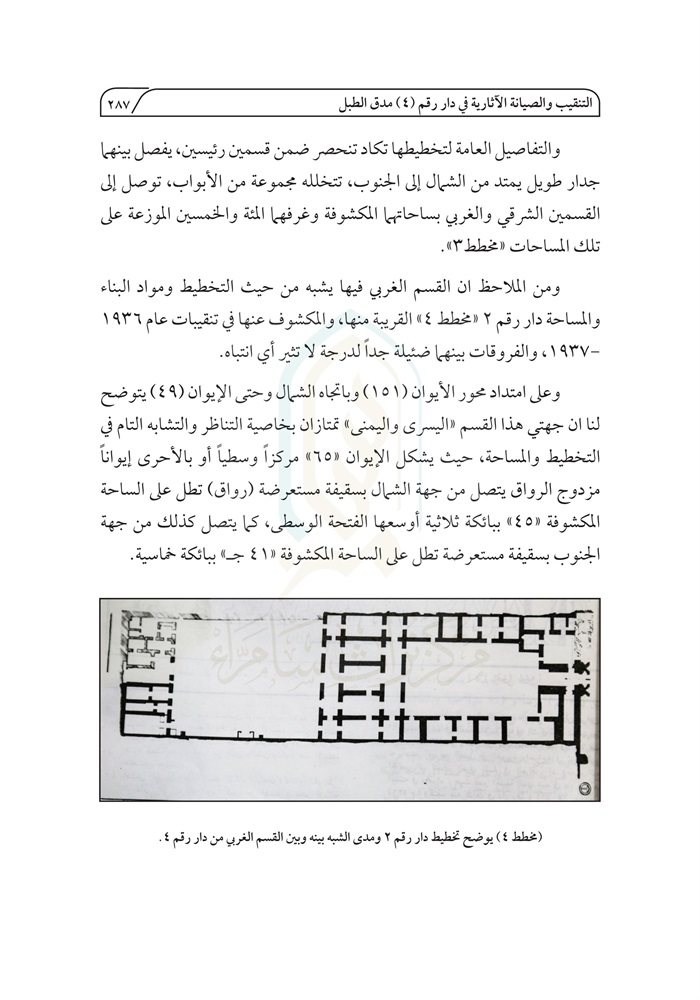
ص: 287
ومن الجدير بالذكر أن القسم الشمالي الشرقي من هذه الدار يكاد ينعزل عن سائر أقسامها بشكل يلفت الانتباه، وهو يحتوي على خمس ساحات (78، 94 ، 102، 108 ، 115) صغيرة مكشوفة، تتصل كل ساحتين متجاورتين بمدخل يوصل بينهما وتتوزع حول هذه الساحات غرف صغيرة يتراوح عددها بين الأربع والست تشكل فيما بينهما ثلاث وحدات سكنية متشابهة ذات مداخل مستقلة في الضلع الشمالي، كما وإن لكل وحدة سكنية حماماً وكنيفاً خاصاً بها.
ويلاحظ ان الغرف الجنوبية لهذه الوحدات مستطيلة الشكل على العموم، وهي تؤدي إلى رواق يفضي بدوره إلى الساحة الوسيطة المكشوفة ببائكة ثلاثية أو ثنائية «يلاحظ المخطط 3».
اما الغرف التي تقع إلى الشمال فهي صغيرة نسبياً، وتفضي إلى الساحة الوسيطة مباشرةً دون سقيفة مستعرضة وأغلبها مرافق وحمامات.
الواقع ان صغر مساحة هذه الوحدات بالقياس إلى بعض الوحدات السكنية من هذه الدار والموزعة حول الساحات (70ب، 41 ج_، 45د، 131، 140) من جهة، وارتباطها مع بعضها بمداخل توصل بين ساحاتها من جهة أخرى، بالإضافة إلى انحصارها في ركن معين من الدار وأبواب مستقلة في الضلع الشمالي دلائل تدفعنا للاعتقاد بان هذا القسم بوحداته السكنية استخدم لسكن القائمين على خدمة صاحب الدار؛ إذ توضح لنا استناداً إلى بعض الدلائل العمارية التي تؤكد ان هذه الوحدات ربطت فيما بعد بالدار حيث الساحة المركزية (9 أ)، وذلك عن طريق ممر أو مدخل ما بين الغرفتين ( 5 ، 85) وبين الغرفتين (8، 100)، وذلك التسهيل عملية انتقال الخدم عبر الساحة المركزية (9 أ) لتأدية الخدمات.
أما القسم الشمالي الغربي فيضم مجموعة غرف تطل على الجانب الشمالي للساحة (45 د)، وهذه الغرف مرتبة ترتيباً منسقاً، حيث تشكل الغرفة (49) أيواناً مفتوحاً
ص: 288
بكامل واجهته على الرواق (47) وفي وسطه تماماً مشكلاً وإياه شكل حرف (T). ما يتصل هذا الأيوان بغرفتين جانبيتين بمثابة الكمين إحداهما إلى اليسار «52» والأخرى إلى اليمين «48» ، ويفتح باب كل منهما على طرفي الرواق «47».
إن نظام توزيع تلك الغرف بهذا الشكل كان معروفاً في العمارة العربية والإسلامية باسم الطراز الحيري. الا أن الرواق هنا لا يفضي إلى الساحة الوسطية مباشرة وانما عبر ثلاث غرف (46 ، 50 ، 51) ، تطل على الساحة الوسطية ببائكة ثلاثية، أوسعها الفتحة الوسطى لبيان أهمية الأيوان الذي يعقب غرفة المدخل.
ومجموعة الغرف هذه غنية جداً بالزخارف الجصية المتنوعة (الأشكال 5، 6،7) (الألواح 31، 32، 37)، وعلى جانبي واجهة الإيوان المفتوحة على الرواق وما يقابلها تبرز أربعة أعمدة جصية (1) (لوح 1) (شكل 8) من بين الزخارف مما تزيدها رونقاً وجمالاً وهذه الأعمدة قائمة على قواعد (2) الحجم (الشكل 8) بارزة قليلاً عن سمت الجدار، ربما كانت تعلوها تيجان كأسية شبيهة بالقواعد على غرار الأعمدة المكشوف عنها في دار (رقم 5) من منطقة مدق الطبل والقريبة من موقع
ص: 289
هذا الدار.
ومن الملاحظ أن الضلع الصغير من ذلك الرواق مزخرف كسائر أضلاعه، الا انه ترك في القسم الأسفل من جهتيه قطعة صغيرة طولها (70 سم) وعرضها 62 سم عارية من الزخارف الجصية، غير انه نقش عليها أشكال تزيينية ملونة تحيط بها كتابة كوفية زرقاء محاطة بإطار مخطط وملون (الشكل 9، 10) اللوح (2 ، 3) يقرأ على الشكل (9) ما نصه ... يشفع عنده الا بإذنه يعلم ...) .
الصورة
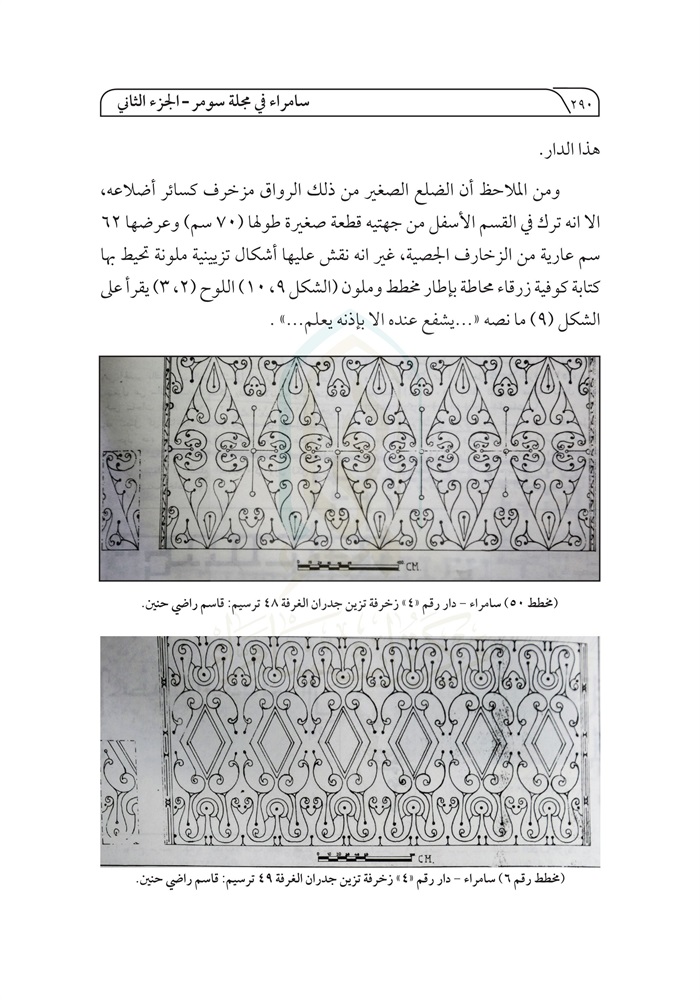
ص: 290
الصورة
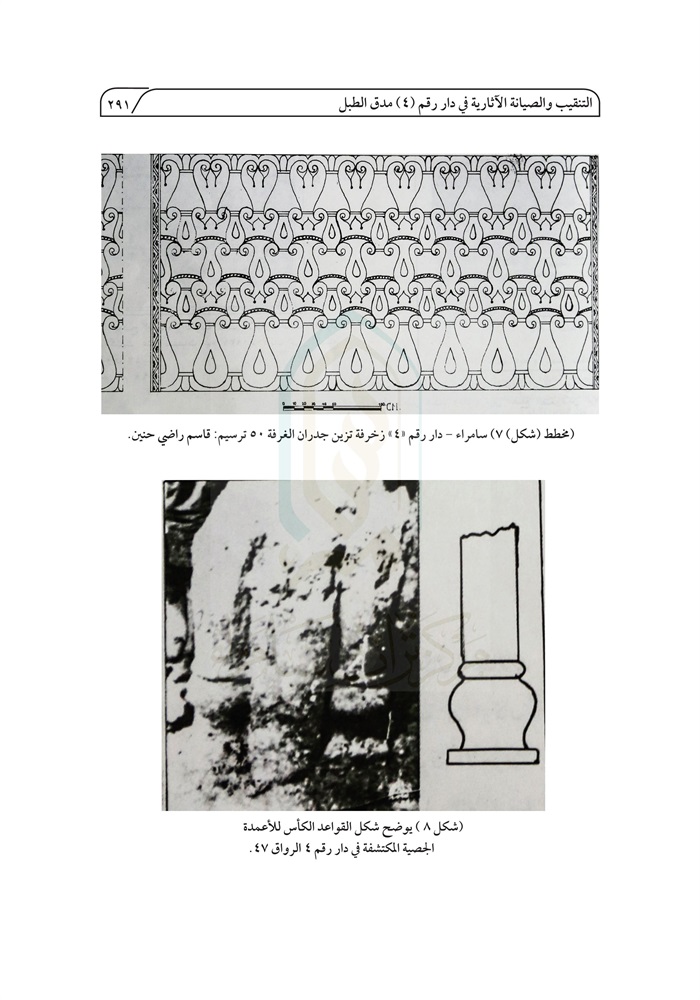
ص: 291
الصورة
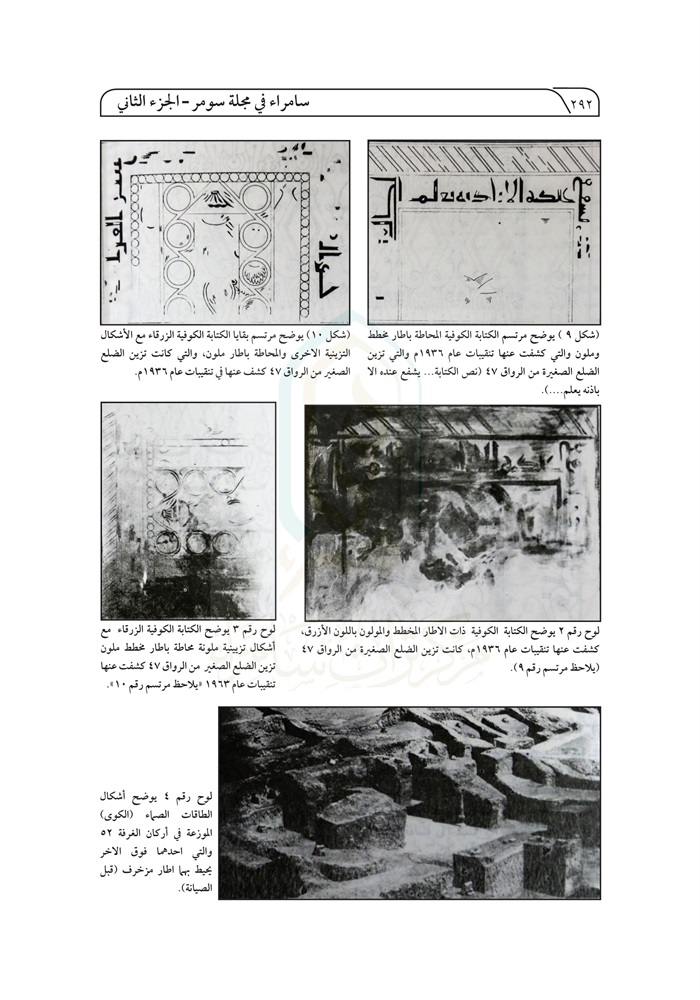
(شكل 9 ) يوضح مرتسم الكتابة الكوفية المحاطة باطار مخطط وملون والتي كشفت عنها تنقيبات عام 1936م والتي تزين الضلع الصغيرة من الرواق 47 (نص الكتابة... يشفع عنده الا باذنه يعلم ...).
(شكل 10) يوضح مرتسم بقايا الكتابة الكوفية الزرقاء مع الأشكال التزينية الاخرى والمحاطة باطار ملون والتي كانت تزين الضلع الصغير من الرواق 47 كشف عنها في تنقيبات عام 1936م.
لوح رقم 2 يوضح الكتابة الكوفية ذات الاطار المخطط والمولون باللون الأزرق، كشفت عنها تنقيبات عام 1936م ، كانت تزين الضلع الصغيرة من الرواق 47(يلاحظ مرتسم رقم 9).
لوح رقم 3 يوضح الكتابة الكوفية الزرقاء مع أشكال تزيينية ملونة محاطة باطار مخطط ملون تزين الضلع الصغير من الرواق 47 كشفت عنها تنقيبات عام 1963 «يلاحظ مرتسم رقم 10».
لوح رقم 4 يوضح أشكال الطاقات الصماء (الكوى) الموزعة في أركان الغرفة 52 والتي احدهما فوق الاخر يحيط بهما اطار مزخرف (قبل الصيانة).
ص: 292
وإلى جانب تلك الزخارف والكتابات والأعمدة زينت أركان الغرفة 52 بطاقات صماء أوكوى «Niches» مقاييسها تنحصر ما بين (35سم) عرضاً و (30 سم) طولا و (25سم) عمقاً موزعاً كل أربعة في جانب حيث يجمع كل اثنين - أحدهما فوق الأخرى- إطاراً زخرفياً مزخرفاً بزخارف نباتية قوامها أوراق كأسية ثلاثية الفصوص (لوح 4 ، 5) ، مما يضفي عليها ظلالاً متفاوتة العمق فتخدم بذلك هدفاً زخرفياً، إذ هي تقطع الملل الذي يحس به النظر إلى جدران ممتدة إلى مسافة طويلة.. بالإضافة إلى استخدامها لحفظ بعض الحاجات.
أما المرافق الواقعة خلف مجموعة الغرف هذه فينفذ إليها عن طريق مدخلين أولهما الركن الشمالي الغربي للغرفة (51) بالزقاق (53) ، ويبدو إن هذا المدخل مستحدث فيما بعد، إذ لا تزال آثار قطع الجدار واضحة وبصورة جلية في الكساء المغاير تماماً للأصل، بالإضافة إلى أن ارتفاع أرضية الزقاق 53 بمقدار 50 سم عن أرضية الغرفة (51) ، والواضح من المخطط ان الزقاق يؤدي إلى المرافق الخلفية لهذه الوحدة التي تضم خمس غرف صغيرة إلى الغرب منه، ثم ينعطف إلى جهة الشرق، حيث تقع ثلاث غرف صغيرة إلى الشمال منه ، وبهذا بشكل الزقاق ما يشبه حرف (L).
والملاحظ ان الغرفة (161) تحتوي طاقات صماء بالإضافة إلى بقايا موقد وكميات كبيرة من الرماد، مما يعزز الاعتقاد بكونها استخدمت كمطبخ بينما نلاحظ في الغرفة المجاورة بئراً، وما بين هاتين الغرفتين وعلى امتداد محور الزقاق يوجد مدخل يفضي إلى خارج الدار في الركن الشمالي الغربي من المرجح انه استخدم لإدخال وإخراج الحاجيات والمؤن ونقل المياه بالإضافة إلى مواد الحرق ومخلفاتها.
ص: 293
الصورة
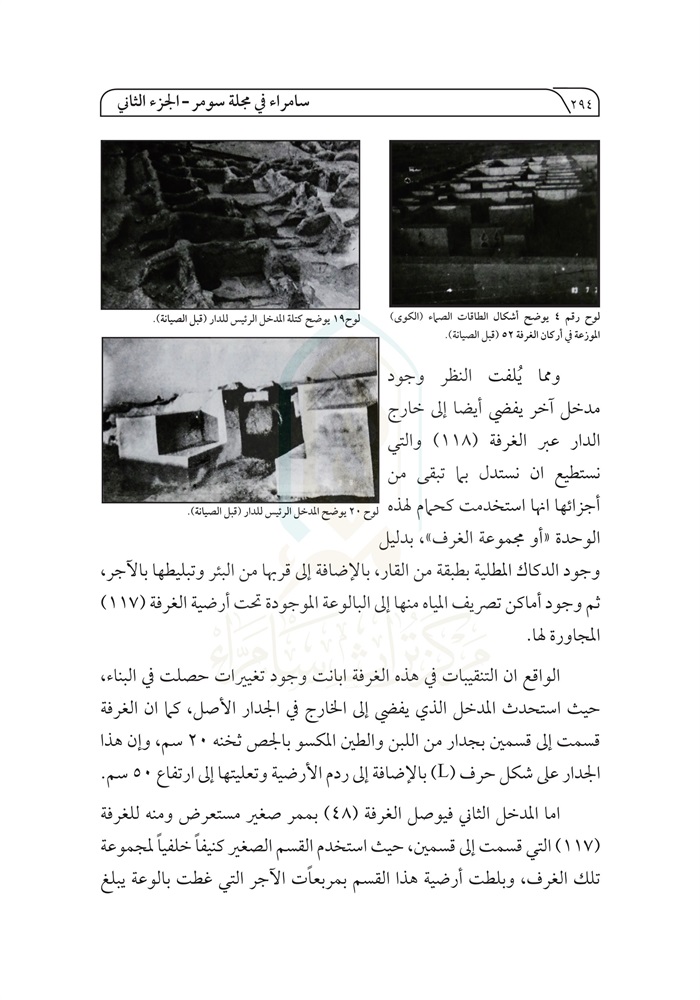
ومما يُلفت النظر وجود مدخل آخر يفضي أيضا إلى خارج الدار عبر الغرفة (118) والتي نستطيع ان نستدل بما تبقى من أجزائها انها استخدمت كحمام لهذه الوحدة «أو مجموعة الغرف»، بدليل وجود الدكاك المطلية بطبقة من القار، بالإضافة إلى قربها من البئر وتبليطها بالآجر، ثم وجود أماكن تصريف المياه منها إلى البالوعة الموجودة تحت أرضية الغرفة (117) المجاورة لها.
الواقع ان التنقيبات في هذه الغرفة ابانت وجود تغييرات حصلت في البناء، حيث استحدث المدخل الذي يفضي إلى الخارج في الجدار الأصل، كما ان الغرفة قسمت إلى قسمين بجدار من اللبن والطين المكسو بالجص ثخنه 20سم، وإن هذا الجدار على شكل حرف (L) بالإضافة إلى ردم الأرضية وتعليتها إلى ارتفاع 50 سم.
اما المدخل الثاني فيوصل الغرفة (48) بممر صغير مستعرض ومنه للغرفة (117) التي قسمت إلى قسمين، حيث استخدم القسم الصغير كنيفاً خلفياً لمجموعة تلك الغرف، وبلطت أرضية هذا القسم بمربعات الآجر التي غطت بالوعة يبلغ
ص: 294
عمقها الحالي ثلاثة أمتار، وتركت فتحة الكنيف تؤدي اليها.
الصورة

لوح 10 يوضح الدكة المستطيلة ذات القطاع النصف اسطواني الذي يتوسطها بثر ربما استخدمت.كمسقی
لوح 11 يوضح دكة شبيهة ل_ (لوح رقم 10) ربما استخدمت كمعلف نظراً لوجود الحنايا الغائرة في سور الدار والتي تضم بداخلها اخشاب مستعرضة ربما استخدمت لربط الخيول.
لوح 25 يوضح الساحة 9 أ وما يحيط بها من غرف قبل الصيانة .
(لوح رقم 8) بقايا زخرفة تزين الجدار الشمالي من الداخل للرواق 16 يمكن مقارنة هذه الزخرفة بمرتسم رقم 11 لمعرفة التشابه بينهما.
شكل 11 يوضح مخطط الزخرفة التي تزين الجدار المحيط بالساحة 9 أ .
ص: 295
الصورة

ص: 296
الصورة
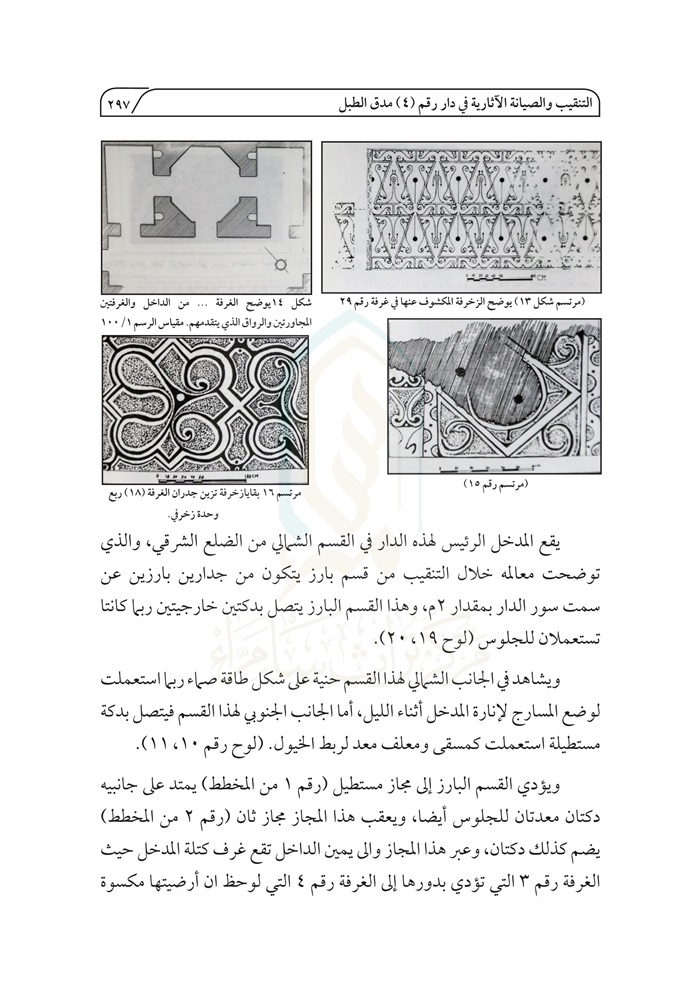
يقع المدخل الرئيس لهذه الدار في القسم الشمالي من الضلع الشرقي، والذي توضحت معالمه خلال التنقيب من قسم بارز يتكون من جدارين بارزين عن سمت سور الدار بمقدار 2م ، وهذا القسم البارز يتصل بدكتين خارجيتين ربما كانتا تستعملان للجلوس (لوح 19 ، 20) .
ويشاهد في الجانب الشمالي لهذا القسم حنية على شكل طاقة صماء ربما استعملت لوضع المسارج لإنارة المدخل أثناء الليل، أما الجانب الجنوبي لهذا القسم فيتصل بدكة مستطيلة استعملت كمسقى ومعلف معد لربط الخيول. (لوح رقم 10 ، 11).
ويؤدي القسم البارز إلى مجاز مستطيل (رقم 1 من المخطط) يمتد على جانبيه دکتان معدتان للجلوس أيضا، ويعقب هذا المجاز مجاز ثان (رقم 2 من المخطط) يضم كذلك دكتان ، وعبر هذا المجاز والى يمين الداخل تقع غرف كتلة المدخل حيث الغرفة رقم 3 التي تؤدي بدورها إلى الغرفة رقم 4 التي لوحظ ان أرضيتها مكسوة
ص: 297
بالجص أولا وبالقير ثانيا مما يعزز القول بكونها استخدمت كحمام إذا اخذنا بعين الاعتبار وجود الدكاك لصق وجه جدارها الشرقي ووجود البئر في الركن الجنوبي الشرقي.
ولقد تعرضت هذه الغرفة إلى تغييرات حصلت في البناء، حيث قسمت إلى قسمين بجدار سمكه 30 سم مبني باللبن الجصي ومادة الجص، كما وإن أرضية الغرفة دفنت إلى ارتفاع 35 سم، والأبواب التي كانت تنفذ إليها سدت واستحدثت ،غيرها، هذا وإن الغرفة رقم 3 تتصل كذلك بالغرفة رقم 5 ومنها إلى الوحدة السكنية التي تقع في القسم الشمالي الشرقي من الدار .
وبهذا نلاحظ ان المدخل الرئيس لا يؤدي إلى الساحة المركزية (9 أ) مباشرة بل یمر خلال المجازين المذكورين، بعدهما ستارة لمنع أنظار المارة في الطريق العام من ان تكشف من بداخل الدار إذا ما فتح الباب الخارجي، بالإضافة إلى أن هذا الانتقال يمنع مرور الرياح والعواصف الحاملة للاتربة والرمال إلى الساحة المركزية (9 أ) ومنها إلى الغرف المطلة عليها .
وبغية توضيح أرضية الساحة المركزية (9 أ) وما يحيط بها من غرف عمدنا إلى رفع الأتربة والأنقاض من أرضيتها التي توضح تبليطها بمربعات الآجر ذي القياس (30×30× 7سم ) إلا انه أثار انتباهنا وجود كسرة في تلك الأرضية دائرية الشكل (لوح 25) مملوءة بالتراب غير المخلوط بالجص، كما وإن لونه مغاير تماما عما حوله من أتربة، مما يعزز القول بكون هذه الحفرة ربما استخدمت كحوض ماء، أو موضع نافورة في وسط الساحة، كما هو مألوف في بعض الدور المكشوف عنها في سامراء، کدار رقم 3 في الشارع الأعظم.
ولقد زينت واجهات الغرف المطلة على تلك الساحة بزخارف نباتية قوامها أوراق كأسية ثلاثية الفصوص مجاور بعضها لبعض زينت المسافة بينهما بمروحة
ص: 298
نخيلية كاملة ثلاثية الفصوص (مرتسم أو شكل 11) (لوح 8 و 35 و 36).
اما الجدران الداخلية لتلك الغرف المطلة على الساحة المذكورة فعارية من الزخارف ما عدا الغرفتين (7) و (29) حيث تقع الأولى إلى الشمال من الساحة والثانية إلى الغرب منها، إذ عثرنا في الغرفة رقم 7 على بقايا زخرفة جصية في أسفل الجدران (مرتسم شکل 12) (لوح 33 و 34) . كما ضم ضلعها الجنوبي محراباً مسطحاً من الجص (لوح 6) يحف به من كل جانب عمود جصي مرسوم، والمحراب مزين بحزوز غائرة ومائلة وبشكل يشبه سعف النخيل، ويعلو العمود تاج كأسي الشكل يشبه إلى حد ما شكل القاعدة ويتوج المحراب قوس توضح بقاياه أنه من النوع المرسوم من أربعة مراكز فيما إذا قارناه بمحراب شبيه به (لوح 7) كان قد عثر عليه في دار رقم (2) والمصنوع من الجص أيضاً، والمتبقي قوسه بشكل كامل، ويبدو أن هذه الغرفة اتخذت كمصلى خاص لأهل الدار من أطفال وشيوخ خاصة في الأوقات التي يتعذر فيها الخروج من الدار إلى جامع الجامعة القريب منها.
اما الغرفة (29) فقد زينت وعلى ارتفاع 60 سم بزخارف جصية قوامها أشكال صلبان متجاورة بعضها لبعض زينت بمراوح نخيلية مقسومة ثلاثية الفصوص (مرتسم أو شكل 13) (لوح 38).
وإلى الجنوب من تلك الساحة (9 أ) امتد التنقيب إلى رواق (16) المؤدي إلى الغرفة المثمنة الأضلاع من الداخل بمثابة الصدر (18)، ومتصلة بغرفتين جانبيتين بمثابة الكمين (17 ، 19) (شكل 14) حيث رفعت جميع الأتربة والأنقاض من مجموعة الغرف هذه فتوضحت بذلك أرضيتها الجصية، كما استظهرت زخرفة تزين أسفل جدران الرواق (16) وهذه الزخرفة شبيهة جدا بتلك المكشوفة عنها والمطلة على الساحة ( 9 أ ) كما أسلفنا ( يلاحظ مرتسم (11) ومقارنته باللوح (8) .
لقد كانت أوجه جدران الغرفتين (17 و 19) عارية تماماً من الزخارف الجصية، اللهم إلا بقايا زخرفة من الطراز الثاني قوامها أوراق كأسية مزينة بنقاط
ص: 299
الصورة
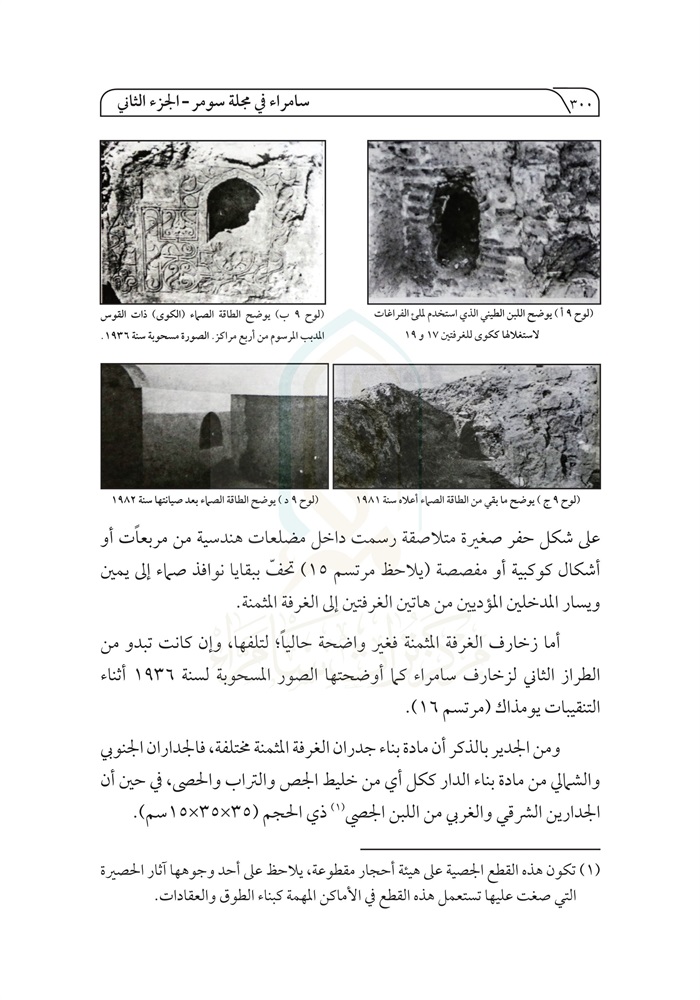
على شكل حفر صغيرة متلاصقة رسمت داخل مضلعات هندسية من مربعات أو أشكال كوكبية أو مفصصة ( يلاحظ مرتسم 15) تحفّ ببقايا نوافذ صماء إلى يمين (15) ويسار المدخلين المؤديين من هاتين الغرفتين إلى الغرفة المثمنة.
أما زخارف الغرفة المثمنة فغير واضحة حالياً؛ لتلفها، وإن كانت تبدو من الطراز الثاني لزخارف سامراء كما أوضحتها الصور المسحوبة لسنة 1936 أثناء التنقيبات يومذاك (مرتسم 16).
ومن الجدير بالذكر أن مادة بناء جدران الغرفة المثمنة مختلفة، فالجداران الجنوبي والشمالي من مادة بناء الدار ككل أي من خليط الجص والتراب والحصى، في حين أن الجدارين الشرقي والغربي من اللبن الجصي (1) ذي الحجم (35×35×15سم).
ص: 300
والفراغات ذات القطاع المثلث التي أحدثتها التقاءات هذه الجدران مع بعضها في ركني الجدار الشرقي للغرفة ،(17)، ومثلهما للجدار الغربي للغرفة (19)، فقد ملئت بمادة اللبن الطيني لوح (9) أ) ذي الحجم 30×30×10سم مع استغلال الفراغ الداخلي ككوى ذات اقواس مدببة مرسومة من أربعة مراكز (الألواح 9 ب، ج، د).
كما لوحظ وجود دعامتين ضمن الجدار الشرقي للغرفة (19) وما يناظرها في الجدار الغربي للغرفة (17) ، وهما يختلفان عن مادة بناء الجدار، حيث شيد الجدار بأجمعه من الطين المخلوط بالجص ،والحصى، بينما شيدت الدعامتان من اللبن الجصي وكل دعامة تقابل ركن مدخل الغرفة المثمنة في كلا الجهتين الشرقية والغربية، مما يثير التساؤل فيما إذا كان هناك عقدان في كل جانب يرتكز كل منها على الدعامة من جهة وركن المدخل من جهة أخرى، وبذلك يمكن القول بوجود سقف من ثلاثة أقبية لكل من الغرفتين (17 ، 19) ، بينما يغطي الغرفة المثمنة (18) قبة إذا اخذنا بعين الاعتبار ثخن الجدران التي تبلغ 1،5 متر ، ومادة البناء لهذه الغرفة التي تتكون من اللبن الجصي ذي القياس (35×35×15سم) ، كما يستدل من ارتفاع الجدران ان القبة كانت مرتفعة، ويغلب على الظن بأن الضوء كان يدخلها عن طريق نوافذ مفتوحة في قاعدتها أو في رقبتها.
مر سابقاً أن الغرفة المثمنة (18) تتصل من الشرق والغرب بالغرفتين (17 و 19) بواسطة مدخلين عرض كل منهما 2 متر ، وهاتان الغرفتان تتصلان و من وسط الضلع الشمالية لكليهما بالرواق (16) ، وهذا الرواق مفتوح بدوره ببائكة ثلاثية على الساحة المركزية ( أ ) ، كما وان طرفه الغربي مفتوح على ممر ضيق يؤدي إلى الساحة المكشوفة (21). اما طرفه الشرقي فيفضي إلى أربع غرف بمثابة مرافق وملحقات متصلة بالرواق (16) ، وبعد الفحص والمعاينة الجدران وأرضيات تلك الملاحق توضح ان الغرفة (13) أعدت كمكان لإعداد القهوة، أو بالأحرى استخدمت كمطبخ ؛ لوجود مواقد النار والدكاك المحيطة بها بالإضافة إلى الطاقات الصماء في
ص: 301
جدرانها والتي استخدمت كأماكن لحفظ معدات إعداد القهوة أو إدوات الطبخ. ثم وجود البئر في الغرفة المجاورة (12) يعزز احتمال استخدام مياهها للشرب أو الغسل، أما بقية الغرف ربما استخدمت للخزن وحفظ المواد.
اما القسم الجنوبي الشرقي من هذه الدار فيضم وحدتين يجمعهما مخطط متشابه وشكل معماري موحد يقوم على مبدأ الفناء المكشوف (131) و (140) الذي تشرف عليه أواوين وغرف على شكل حرف (T)، بالإضافة إلى بعض المرافق والملاحق على جانبي الفناء، وكل من هاتين الوحدتين ترتبط بالساحة (160) ومجموعة غرف الحمام والمرافق لكل منهما عن طريق ممر ضيق خاص بكل منها في الجانب الشرقي ومن الساحة (160) إلى مدخل القسم الجنوبي الشرقي لهذه الدار، كما تتصل هاتان الوحدتان وعبر مدخلين في كل منها في الجانب الغربي إلى الساحة (41 ج_) ، في حين لم تكشف التنقيبات عن مدخل يوصل بينهما، بينما كشفنا عن مدخل يوصل الساحة (131) بالساحة (129) وعبرها إلى مجموعة غرف الساحة (70ب).
والملاحظ ان مجموعة غرف هذه الساحة تكاد تكون مستقلة إلى حد ما بالإضافة إلى أن أرضيتها ترتفع عن مستوى أرضية غرف وساحات القسم الجنوبي الشرقي (1) م) متراً واحداً، وتنخفض عن أرضيات غرف الساحة (21) بمقدار (1 م)، كما لا يوجد لها مدخل مستقل في الضلع الشرقي للدار كما أوضحتها تنقيبات سنة 1936 عبر الغرفة (124) في الركن الجنوبي الشرقي لهذه الوحدة، حيث توضح لنا ان المدخل الذكور عبارة عن دخلة بالجدار بعمق (50سم) وان الغرفة فيما يبدو استخدمت حماماً لهذه الوحدة حيث رصفت أرضيتها بالحصى ذي الحجم الكبير والجص وذلك لتفادي تأثير الرطوبة والمياه المستعملة، وان أرضيتها ذات مستوى مائل نحو الكهريز الذي يقع في الركن الجنوبي الشرقي منها، وعن طريقه يمكن تصريف المياه، بالإضافة إلى أن أسفل أوجه جدرانها مطلية بالقار والى ارتفاع 60 سم ؛ وذلك لتفادي انتقال الرطوبة إلى الجدران.
ص: 302
وتتصل هذه الغرفة بالغرفة 125 عبر مدخل في ضلعها الجنوبية، والملاحظ أن أرضية هذه الغرفة ترتفع عن مستوى أرضية الغرفة (124) بمقدار 50 سم، إذ توجد بقايا دكاك لصق جدرانها مما يعزز الاعتقاد بكونها غرفة منزع للتهيؤ لدخول غرفة الحمام. بالإضافة إلى أن أقسام من جدرانها زينت بالكتابات الكوفية البارزة بين الزخارف الجصية (مرتسم 17 ، والتي تتضمن مقاطع من آية الكرسي، نصها (ولا يحيطون بشي م_...) .
ثم نعود إلى التخطيط الخارجي لهذه الدار، وأول ما يلفت النظر فيه الواجهة الشرقية التي تختلف عن الواجهات الاخرى؛ لوجود الأبراج التي تدعمها، وهي نصف اسطوانية قطرها (2م) غير قائمة على قواعد سواء كانت تلك القواعد مربعة أو مستطيلة المقطع، بالإضافة إلى خلو الأركان من تلك الأبراج التي تدعمها كما هو مألوف في بعض الدور والقصور المكشوف عنها في سامراء، وهذه الأبراج موزعة على تلك الواجهة اثنان إلى يسار المدخل الرئيس، ومثلهما إلى يمينه.
الصورة
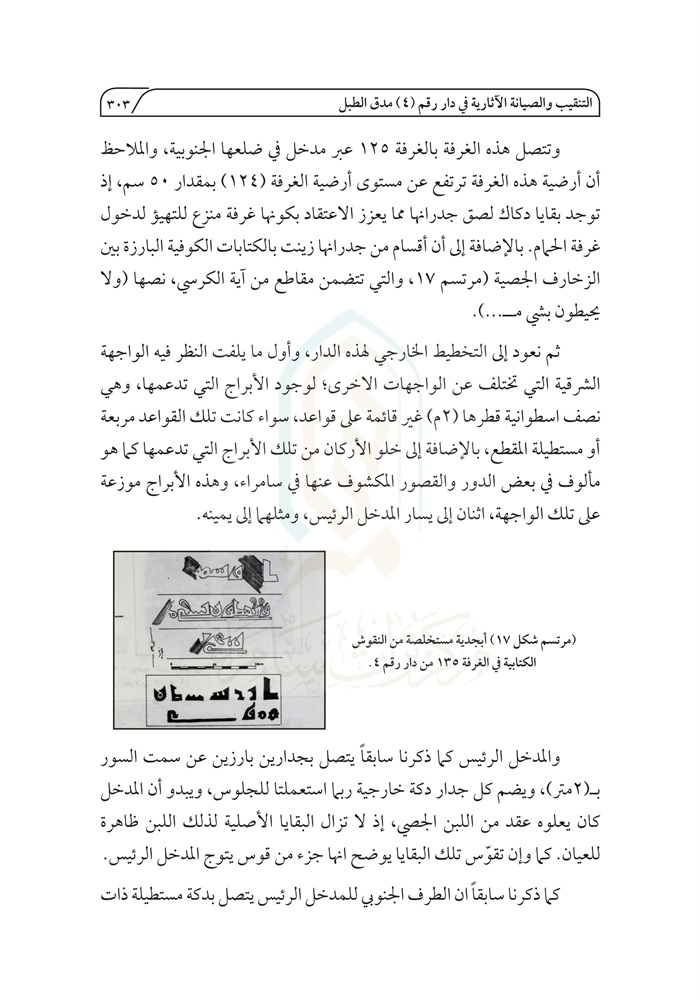
والمدخل الرئيس كما ذكرنا سابقاً يتصل بجدارين بارزين عن سمت السور ب (2) متر)، ويضم كل جدار دكة خارجية ربما استعملتا للجلوس، ويبدو أن المدخل كان يعلوه عقد من اللبن الجصي ، إذ لا تزال البقايا الأصلية لذلك اللبن ظاهرة للعيان. كما وإن تقوّس تلك البقايا يوضح انها جزء من قوس يتوج المدخل الرئيس.
كما ذكرنا سابقاً ان الطرف الجنوبي للمدخل الرئيس يتصل بدكة مستطيلة ذات
ص: 303
قطاع نصف اسطواني تمتد حتى البرج الثالث يتوسطها بئر، ترتفع هذه الدكة عن مستوى سطح الأرض بمقدار (1 متر) ربما أعدت لتكون مسقى للابل أو الخيول، فيما اذا اخذنا بعين الاعتبار وجود فتحات دائرية في رقبة البئر التي تنتهي ونهاية القطاع نصف الأسطواني لهذه الدكة؛ مما يعزز القول بملء هذا المسقى بالماء من البئر بواسطة البكرة والدلو بعد غلق فتحات رقبة البئر ، وعند فتحها تتسرب المياه من المسقى إلى البئر ثانية ( يلاحظ اللوح 10).
والى جانب هذا المسقى، أي بين البرج الثالث والرابع، توجد دكة شبيهة بالأولى، ليست لها بئر، وقد لوحظ وجود حنايا غائرة في سور الدار ترتفع ونهاية الدكة. وهذه الحنايا تضم بداخلها أخشاباً بشكل مستعرض، ربما استخدمت هذه الأخشاب لربط الخيول، وتلك الدكة كمعلف لها (لوح 11)، إذ الراجح لدينا ان أصحاب هذه الدار كان بحوزتهم ثلاثة حيوانات أو أربعة (1). تقف بجوار الدار، ولم يكن لها مكان بداخله (2).
ومن كل ما سبق من تنقيب برزت أمامنا بعض الظواهر العمارية التي يمكن أن نستعين بها على الوصول إلى معرفة ما كانت عليه التصميمات الأولى لهذه الدار، وهي: -
ص: 304
الصورة
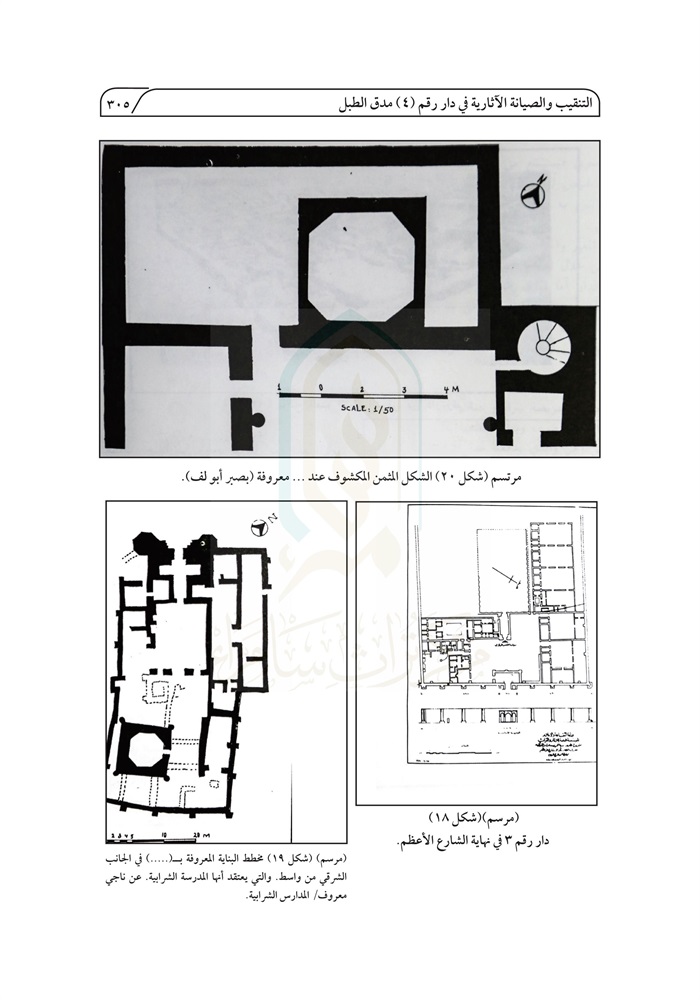
ص: 305
الصورة

أولاً:-
تكشف التنقيبات أحياناً عن وجود فواصل بين الجدران، والتي تفسر أنها جدران مضافة في فتراتٍ زمنية لاحقة للبناء غير أنه يمكن في بعض الحالات اعتمادها في تفسير إضافة بعض أجزاء للبناء، ومن ذلك ما نراه في هذه الدار. فإنه يرجح لدينا ان البناء الأصلي يبدأ من البرج الثاني من الشمال وحتى الركن الجنوبي الشرقي للدار ، ثم تمكن مالك الدار فيما بعد من بناء القطعة المجاورة التي ضمت القسم الشمالي من الدار (لوح 12)؛ وهي تشكل وحدات بنائية تضم فناء مكشوفاً منتظم الشكل تحيط به غرف كما اسفلنا - جعلها ملحقات بالدار عن طريق مداخل استحدثت بالجدار الأصلي كالتي بين الغرفتين 5 ، 85 و 100 ، 8 و 53 ، 51 ، ويمكن ملاحظة هذه الفواصل بوضوح بين الجدارين المتجاورين الإيوان 50 والرواق (47)، بالإضافة إلى المداخل التي استحدثت بقطع جدار الإيوان وجداري الغرفتين 46 و 51 إلى الرواق 46 .
ص: 306
ولا يفوتنا أن نذكر أن كتلة بناء الغرفة المثمنة (1) والغرفتين المجاورتين والرواق الذي يتقدمهم، تبدو وكأنها قد أضيفت إلى مخطط الدار بوجه عام فيما بعد. أو بمعنى أنها حشرت حشراً في القسم الجنوبي من الساحة (9 أ) وليست من ضمن التصميم الأساس لمخطط الدار، والذي يؤيد ما ذهبنا إليه هو أن الحفريات أوضحت امتداد الجدار الجنوبي لهذه الكتلة والذي يشكل النهاية الجنوبية للساحة (9 أ) والتقائه بالجدار الجنوبي لكل من الغرفتين (26 و 37) حيث توضح بعد التنقيب بقايا أسس امتداد هذا الجدار قاطعاً الممر الضيق الذي يفصل بين الغرفتين (17 و 27) والمؤدي إلى الساحة المكشوفة (21)، إضافة إلى أن مستوى أرضية هذه الكتلة أعلى من مستوى أرضية الساحة (21) والممر الضيق بمقدار (1 متر) مرتسم (شكل12) .
ثانياً : -
لم نعثر في هذه الدار على نوافذ أو شبابيك كبيرة تطل على الطرق المحيطة بها بالرغم من أن متوسط ارتفاع الجدران في معظم أقسامها متران، فنستنتج من ذلك أن أصحاب الدار كانوا حريصين غاية الحرص على المحافظة على حرمات من بداخله، وهو قيد أو شرط التزم به المسلمون عند بنائهم دورهم منذ أوائل العصر الإسلامي.
وقد اعتمد المعمار والحالة هذه أن تستمد الدار الضوء والهواء بصفة رئيسة من خلال الساحات المكشوفة التي تتوسط الوحدات السكنية لهذه الدار، أما نوافذ الطوابق العليا إن وجدت فهي صغيرة وترتفع عن أرضية الطابق أكثر من مترين حتى لا يتمكن
ص: 307
شخص متوسط الطول من أن يطل منها على الجيران؛ لان المسلمين حريصون على ألا يشرفوا على منازل الآخرين.
الصورة

لوح 13 يوضح القنوات المحفورة في الجدران والتي تضم بداخلها أنابيب الفخار النازلة من الأعلى للتخلص من المياه والفضلات بتصريفها
لوح 39 يوضح استخدام الخشب (القوغ) بصورة عمودية داخل الجدران من الجهتين وتمتد وارتفاع الجدار (بعد الصيانة).
ص: 308
ثالثاً: -
إن عمل جدران عريضة يتراوح سمكها في الغالب بين المتر والمترين في الطابق الأرضي، وبناء معظمها باللبن الجصي ، يمكن أن تتحمل طابقاً آخر، والذي يدفعنا لهذا الاعتقاد وجود السلالم التي تؤدي إلى الأعلى في أكثر من موضع (1). بالإضافة إلى وجود القنوات ذات المقطع المربع أو المستطيل المحفورة في الجدران والتي تضم بداخلها أنابيب الفخار (لوح 13) النازلة من الأعلى للتخلص من المياه والفضلات بتصريفها إلى الكهاريز المحفورة تحت الأرضيات هي كذلك شواهد يمكن الاستدلال بها على إن هذه الدار كانت تضم طابقاً اخر ربما استخدم كأجنحة مخصصة للحريم وحجرات للنوم إلى غير ذلك من الوحدات المكملة لها.
رابعاً : -
من التقاليد العمارية التي تستلفت الانتباه في أغلب مباني سامراء المشيدة بالآجر هي التقوية بالأربطة الخشبية التي توضع ممتدة على طول الجدران من الجهتين أولاً، وبعرض الجدار ثانياً، وذلك لتقوية الجدران من ناحية ولتوزيع الثقل فوقها بقدر الأمكان من ناحية اخرى، ولا زالت تلك الأخشاب ظاهرة للعيان في أماكن و في اخرى حيزها الذي كانت تشغله في البناء والتي انتزعت منه كما في قصر الخليفة وقصر المعشوق، وبقدر ما يتعلق هذا التقليد العماري في بناء الدار التي نحن بصددها دار رقم 4 نلاحظ أن شكل الأخشاب وطريقة استخدامها تختلف عما ذكرناه سابقاً، حيث استخدمت في هذه الدار بصورة عمودية داخل الجدران من الجهتين وتمتد وارتفاع الجدار، وهي اسطوانية الشكل (فوق) (لوح رقم 39)، في حين ما عثر عليه في قصر الخليفة وقصر المعشوق منشورية الشكل (طرويز).
ص: 309
إن وضع هذه الأخشاب بصورة عمودية داخل الجدار وارتفاعها وإياه يقلل من الثقل المسلط على الجدار أولاً ويسهل ربطها مع عوارض خشب السقف ثانياً، إذ الراجح لدينا إن الأسلوب المتبع في تسقيف هذه الدار كان بواسطة الأخشاب الممتدة عرضياً على الجدران والتي تحمل سقفاً، مستوياً، وذلك لانه لم نعثر على ما يشير إلى استخدام الأقبية في التسقيف بالرغم من إن بعض الجدران وصلت إلينا بحالة جيدة، ومتوسط ارتفاعها يصل إلى ثلاثة أمتار وهو الارتفاع المطلوب الذي تبدأ وإياه العقادة إن وجدت.
بالإضافة إلى أنه وجد بين الأنقاض و في وسط الغرف كمية كبيرة من القطع الجصية التي على أحد وجوهها الحيز الذي كان يشغله القصب، مما لا يدع يدع مجالاً للشك في إن القصب استخدم كوسادة لتغطية الحصران (1) المفروشة على عوارض خشب السقف (2)
. ثم سيعت تلك الوسادة بطبقة من الجص، ثم تكملة التسقيف.
خامساً : -
لوحظ أن بعض جدران الدار قائم على كتل مقطوعة من الأرض البكر وبثخن
ص: 310
الجدران القائمة عليها، ثم مكسو والجدار بطبقه من الجص، وإذا أخذنا بعين الاعتبار إن بناء سامراء قائم على مصطبة من الأرض الصلبة التي تضم عدداً كبيراً من التلول التي تأخذ شكل التموجات؛ نستنتج من ذلك إن المعمار استغل عند بنائه بعض جدران القصور والدور الأجزاء الصلبة من تلك التلول ولم يزلها بل بنى فوقها، وقد تبين لنا ذلك في الدار التي نحن بصددها «دار رقم 4174 »، حيث توضح بعد التنقيب إن أرضياتها ذات مستويات مختلفة، يلاحظ مرتسم (شکل 21)، وعند التحري والتدقيق لوحظ أنّ الجدران تبدأ مع مستوى الأرض الطبيعية؛ أو بمعنى أن الأرض المنخفضة تبدأ معها الجدران، وكذلك الأرض المرتفعة تبدأ الجدران فيها من نهاية إرتفاعها دون حفرها إلى مستوى الأرض المنخفضة، ثم يرتفع بالجدار إلى مستوى واحد؛ أما داخل الغرف والساحات فقد أزيلت الأتربة التي بها وجعلت الأرضية مستوية. وبهذا استفاد المعمار من هدفين:
أولهما: الاستفادة من الأتربة المرفوعة، حيث استخدمت في البناء.
وثانيهما: إن هذا الأسلوب ساعد على سرعة إنجاز المبنى.
وعند تغطية الجدران بالجص غطيت أجزاء الجدران الطبيعية بحيث تبدو للعيان وكأنها جدران مبنية وليست جدران طبيعية. وقد كشفنا عن ذلك بالتحري الأثري في هذه الدار، وتتبعنا ذلك في أكثر من مكان في شمال ووسط وجنوب سامراء (1).
ص: 311
سادساً : -
من المعروف أن تخطيط سامراء جاء وفق تصميمات هندسية مدروسة حددتها خطوط متوازية بمثابة الشوارع والطرق والأزقة حصرت بينها الدور والقصور ثم وزعت بأسلوب القطائع. كان مبدأ بعدها أو قربها من قصر الخليفة يعتمد منزلة وأهمية الشخص الساكن لها. ولما كانت هذه الدار - دار رقم (4) على مسافة قريبة من قصر الخليفة لا تزيد على 450 متراً - كما أسلفنا - ثم إن سعتها وكثرة مرافقها وغرفها بالإضافة إلى تزيينها بالزخارف الجصية البديعة والمتنوعة (1) دلائل تدفعنا للاعتقاد بأن ساكن هذه الدار من المقربين للخليفة وذو منزلة مهمة.
كما لا يفوتنا أن نذكر بأنه قد عثر في أحد الدور المجاورة لهذه الدار على نقوش مزينة بالألوان بعضها مغشاة بطبقة من ماء الذهب مما يعزز الاعتقاد بان هذه الدار كانت ضمن مجموعة الدور التي يمتلكها بعض أغنياء وأثرياء سامراء في ذلك العصر، بالإضافة إلى قربهم ومنزلتهم لدى الخليفة.
الزخارف الجصية : -
كشفت التنقيبات ما كانت عليه مدينة سامراء، وما ازدانت به جدرانها من زخارف وبوجه خاص المحفور منها على الجص ، ولقد نالت هذه الزخارف بصورة عامة دراسة تحليلية مفصلة من لدن علماء الآثار، وحظيت الزخارف الجصية بالنصيب الأوفى لكثرتها وتنوعها. وقد اختلفت بصددها الآراء، ثم اجتمعت أخيراً على رأي واحد هو إنها تنقسم إلى ثلاثة طرز أو أساليب متباينة كما حددها المختصون (2)، وإن أول
ص: 312
هذه الطرز ( Style A ) الذي يعتمد على عنصر ورقة العنب الخماسية الفصوص ذات العروق الواضحة، والثقوب المستديرة الغائرة في زواياها وقطاعها يميل إلى التقعر، وعنصر ورقة العنب الثلاثية الفصوص، وعنقود العنب ذي المحيط المكون من ثلاثة فصوص وله قطاع محدب، مشغولة مساحته بأنصاف كرات مجوفة (حبيبات) رتبت بصورة منسقة ومنظمة، ثم العناصر الكأسية ذات القطاع المحدب والمزينة مساحتها بأشكال معينات غائرة أشبه بخلية النحل ، أما اسلوب الحفر فيه فيعرف بالحفر العميق، وقد كان مألوفاً قبل الإسلام وبعده.
والطراز الثاني (Style B ) هو امتداد لأسلوب الطراز الأول من حيث رسم العناصر الزخرفية داخل مضلعات من مربعات ومعينات أو أشكال كوكبية، حيث تظهر هذه الأشكال ممتزجة بأشكال نباتية بعيدة عن الطبيعة في رسمها، ولقد اختصرت في هذا الطراز الأرضيات (الخلفيات) back ground التي أصبحت خطوطاً عميقة تفصل بين العناصر الزخرفية التي تطورت إلى وحدات كبيرة منبسطة لا تجسيم فيها،
ص: 313
ويكمل بعضها البعض الآخر بحيث لا تترك أرضية أو فراغاً.
ومن أهم مميزات هذا الطراز الميل إلى قلة التأنق في تصميم وتوزيع العناصر الزخرفية، واختصار الحشو الداخلي لبعضها، فمثلاً العناصر الكأسية التي كانت في الطراز الأول أشبه بخلية النحل أصبحت في الطراز الثاني عبارة عن حفر صغيرة متلاصقة، وكذلك عناقيد العنب أصبحت مساحتها مشغولة بنقاط متفرقة وبغير انتظام.
أما الطراز الثالث ( Style C ) والذي يهمنا هنا ؛ لأنه يزين جدران هذه الدار (دار رقم 4) ، فهو يمتاز بطابع خاص في مظهره يميزه بسهولة عن الطرازين السابقين، إذ اعتمد المراوح النخيلية بأشكالها المختلفة بشكل مبسط، لتكون أكثر صلاحية لفكرة الصب في قوالب واستخراج نسخ متكررة من الزخرفة الواحدة؛ لتغطية المساحات الواسعة المراد زخرفتها مما ساعد على توفير الوقت والجهد والتكاليف وهي طريقة أسهل بكثير من طريقة الحفر المباشر التي اتبعت في الطرازين الأول والثاني.
والحقيقة أن العناصر الزخرفية في هذا الطراز قد تبلورت بشكل واضح، إذ ازداد ابتعاد الفنان عن الطبيعة ازدياداً جلياً، وأصبح يرسم خطوطاً منحنية وحلزونية قد يصعب على المرء إدراك الصلة بينها وبين الزخرفة النباتية التي تطورت عنها ك_ (المراوح النخيلية الكاملة ( مرتسم 11، 12 لوح 8) والمقسومة (مرتسم 5 لوح 32) والعناصر الكأسية (مرقم 6 لوح 30، 31) وحلزونات وأشكال أخرى (المرتسمات 7، 12 ، 13)، حيث تظهر في هذا الطراز وقد اختزل منها الحشو الداخلي وأصبحت مقتصرة على المحيط الخارجي، يسمي أمثالها كونك (المراوح النخيلية المجنحة) (1) Flip palmettre (لوح 6) ، ولم تقف عند هذا الاختزال، بل أصبح لطرفها
ص: 314
العلوي التواء قوي بالإضافة إلى الالتواء الذي بقاعها، وصار لها شكل يشبه البلطة سماها الدكتور لام(1) leaf puivin وسماها الدكتور زكي محمد حسن(2) الكلوة أو الكلية (لوح 14) . وقد أصبحت مثل هذه العناصر من مميزات الأسلوب أو الطراز العباسي. ومن الملاحظ أن أنصاف المراوح النخلية والأوراق الكأسية لم تشكل في هذا الطراز وحدات زخرفية قائمة بذاتها، بل تداخلت مع السيقان لتتفرع منها أنصاف مراوح نخيلية أو أوراق كأسية أخرى، أو بمعنى ان يمتد طرف العنصر منها، حتى يصبح بهيئة ساق ينبت منه عنصر آخر (المرتسمات 5، 6 ، 7 الألواح 14، 30، 37 ،31،32 )
إن جعل الموضوعات الزخرفية المتماثلة تتداخل بعضها ببعض أولاً، ووضع الوحدات المختلفة جنباً إلى جنب ثانياً، قد أظهر تلاصق العناصر وكأن بعضها يكمل البعض الآخر، ولا تترك فراغاً بينها، أي لم تعد هناك خلفية للزخرفة. أو بمعنى آخر: إن السطح الذي عليه الزخارف يكون مغطى كله فلا يكاد يظهر من الأرضية (الخلفية) شيء، وإن المرء ليحار، هل الزخرفة نتيجة الاتصال الخطوط المنحنية والحلزونية بعضها ببعض أم هي حادثة من السطوح التي تحصرها تلك الخطوط بينها؟ وهذا ما امتاز به الفن الإسلامي فيما بعد من كراهية الفراغ في الزخرفة؛ ولغرض اتباع طريقة الصب في قوالب كما أسلفنا كان ولا يزال يتبع الفنان طريقة الحفر المائل (slant cut) ، أولاً، والتخلص من الأرضيات العميقة ثانياً، فكلاهما يسهلان كثيراً عملية الصب في قوالب وانتزاع القالب بعد صبّه، ولكن ليس من الضروري أن تكون طريقة الصب قد اتبعت في جميع الأحوال، إذ من المؤكد بعد التدقيق في بعض الغرف التي تتشابه فيها الزخرفة من حيث العناصر وأسلوب الحفر لم تكن المقاسات وأشكال العناصر متساوية على وجه الدقة، وخاصة فيما إذا أخذنا
ص: 315
الزخرفة التي تغطي عرضي غرفة أو طولي غرفة من غرف هذه الدار وقارنّاهما مع بعضهما، لوجدنا هناك فروقاتٍ كثيرة.
إن الألواح الجصية المزخرفة لم تثبت على الجدران مباشرة، وانما بعد طلي الجدران بطبقة من الجص بوجه عام، ثم تثبت لصق طبقة الطلاء هذه طبقة أخرى من الجبس، عليها زخارف محفورة في الأقسام السفلى من جدران القاعات والغرف الأساسية.
الواقع إن ما تبقى من الزخرفة في غرف وقاعات هذه الدار يرتفع عن الأرضية عند الكشف عنها بمقدار متر واحد ، غير أنها فيما يبدو ترتفع أكثر من ذلك على جانبي المداخل، مما يعزز الاعتقاد بكونها ترتفع مع المداخل لتكون إطاراً مزخرفاً تحيط به، وقوام الزخرفة فيه سلسلة من حلقات أو كرات متصلة ببعضها أو ضفائر مختلفة.
مواد البناء
إن بعض غرف الدار، كالغرفة المثمنة والغرف المحيطة بها مبنية باللبن الجصي ذي القياس 35×35×15سم ، ومادة الربط الجص. غير أن سائر أقسام الدار مبنية بخليط الجص والتراب والحصى وبشكل يشبه الطوف، ونادراً ما استعمل اللبن الطيني ذي القياس 30 سم × 30سم× 10 سم مع مونة الجص كمادة رابطة، في بعض أقسام الدار.
اما التبليط الأرضي فكان على نوعين: -
1 - الساحات والممرات المكشوفة تبلط بمربعات الآجر ذي القياس 30×30×7 سم، والحالة التي ظهرت بها أرضيات هذه الساحات من تحت الأنقاض تدل على إتقان كبير في صناعة الآجر من جهة، وأعمال التبليط من جهة أخرى.
ولقد كانت طريقة تبليط هذه الأرضيات يتم بصف مربعات من الآجر وبصورة متوازية طوليا وعرضياً تتقاطع مع بعضها، ومن هذا التقاطع نشأ مساحات
ص: 316
الصورة
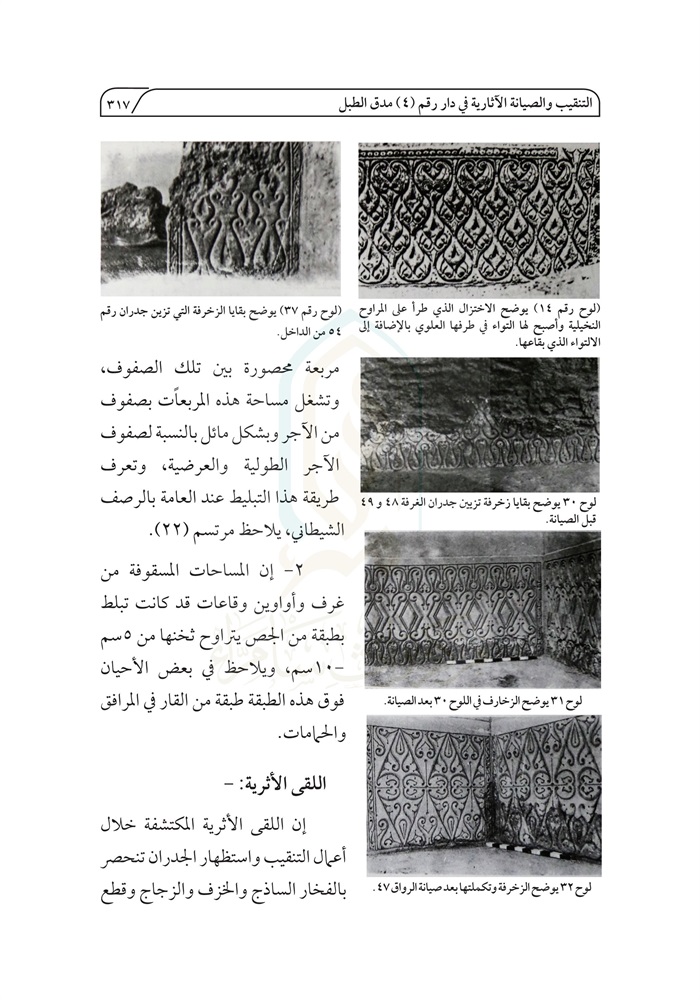
(لوح رقم 14) يوضح الاختزال الذي طرأ على المراوح النخيلية وأصبح لها التواء في طرفها العلوي بالإضافة إلى الالتواء الذي بقاعها.
(لوح رقم 37) يوضح بقايا الزخرفة التي تزين جدران رقم 54 من الداخل.
لوح 30 يوضح بقايا زخرفة تزيين جدران الغرفة 48 و 49 قبل الصيانة.
لوح 31 يوضح الزخارف في اللوح 30 بعد الصيانة.
لوح 32 يوضح الزخرفة وتكملتها بعد صيانة الرواق 47 .
مربعة محصورة بين تلك الصفوف، وتشغل مساحة هذه المربعات بصفوف من الآجر وبشكل مائل بالنسبة لصفوف الآجر الطولية والعرضية، وتعرف طريقة هذا التبليط عند العامة بالرصف الشيطاني، يلاحظ مرتسم (22).
2- إن المساحات المسقوفة من غرف وأواوين وقاعات قد كانت تبلط بطبقة من الجص يتراوح ثخنها من 5سم -10سم، ويلاحظ في بعض الأحيان فوق هذه الطبقة طبقة من القار في المرافق والحمامات.
اللقى الأثرية -
إن اللقى الأثرية المكتشفة خلال أعمال التنقيب واستظهار الجدران تنحصر بالفخار الساذج والخزف والزجاج وقطع
ص: 317
الرخام والمرمر والجص، وبعض القطع المعدنية. (الألواح 15، 16، 18).
فقد عثر على كميات من كسرات الفخار تعود لأوان وجرار مختلفة بعضها عليها حزوز متنوعة، وبعضها عليها طبعات دائرية عليها نقوش بشكل خطوط ونقاط بارزة، كما إن الطينة ظهرت أحياناً بلون أحمر، إضافة إلى بعض الفخار ذي الطينة الصفراء الرقيقة الجيدة الصناعة، وقد عثر على مقابض بعض الأواني الفخارية والجرار ما يشبه القرص أو الوردة المفصصة.
والخزف الذي اشتهرت به سامراء وكانت تصنع منه الأواني والصحون فقد عثر على كميات كثيرة من الكسرات والقطع غير الكاملة، والتي ظهرت ذات لون أخضر أو أزرق أو أبيض، ثم ذات ألوان متعددة بشكل مخطط مقلم و مبقع أو منقط، ثم الذي يحمل نقوشاً تحت التزجيج مع بعض الكسرات ذات البريق المعدني من النوع الذي ظهر في سامراء وشاع استعماله بعد ذلك في العالم الإسلامي آنذاك، وهناك قطع من الخزف تحمل نقوشا بارزة، وهي ذات لون واحد هو الأزرق في الغالب.
والزجاج المكتشف معظمه كسرات رقيقة الصنع تعود لقناني صغيرة عثر عليها في الأنقاض، وقد عثر على بعض القناني الكاملة بعضها من الزجاج الأبيض والبعض الآخر أخضر غامق، بالإضافة إلى ذلك عثر على بعض المقابض الصغيرة المختلفة.
أما كسر الرخام والمرمر فهي ملساء غير مزخرفة يبدو أنها استعملت كحافات أسفل الجدران، أو أنها استخدمت كجزء من الأرضيات.
كما عثر على مجموعة من الكسر الجصية المزخرفة والمدفونة في الأنقاض التي رفعت من وسط الغرف، وهي مما لا شك فيه كانت قد سقطت مما لا شك فيه كانت قد سقطت من أوجه الجدران
التي كانت تزينها.
ص: 318
الصورة
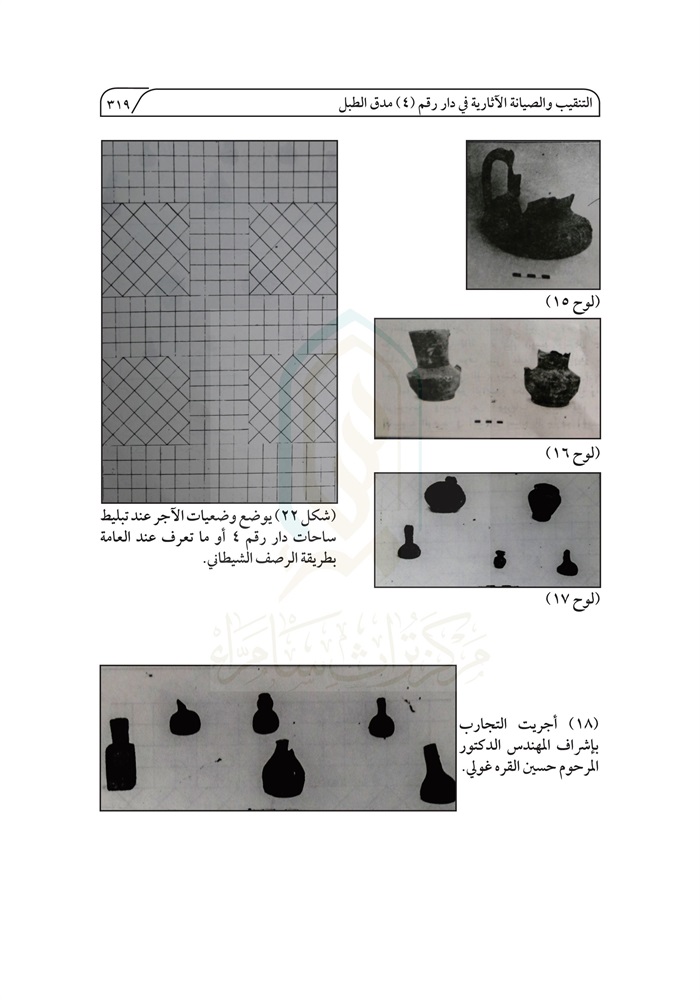
ص: 319
القسم الثاني
أعمال الصيانة والترميم: -
الواقع إن أقسام هذه الدار كانت عند الكشف عنها عام 1926 / 1939 على درجة كبيرة من الحفظ، كما أوضحتها الصور الفوتوغرافية المسحوبة حينذاك، غير انه منذ ذلك الوقت تساقط الكثير من أجزائها بفعل عوامل الطبيعة ويد الإنسان العابثة.
بالإضافة إلى ذلك أن تنقيبات عام 1936 كانت قد افتقت اوجه الجدران فقط ورفع الأتربة والأنقاض إلى وسط الغرف والساحات؛ فبدت وكأنها تلال صغيرة منتشرة في رقعة الدار، تتخللها الخنادق التي أصبحت فيما بعد أماكن لتجمع مياه الأمطار التي ادت إلى انهيار قسم من الجدران وتلف القسم الأكبر من الزخارف الجصية التي تزينها.
وبغية الحفاظ على البنية من الجدران والزخارف التي تعرضت وتتعرض إلى عوامل التعرية والتآكل من أمطار ورطوبة وتفاوت في درجات الحرارة التي تؤدي إلى تشقق الجدران وتفتت الزخارف وسقوطها ؛ ارتأت المؤسسة العامة للآثار من الضرورة الإسراع في صيانتها وترميمها وإعمارها للحفاظ عليها من العوامل التي أشرنا إليها والتي أصبحت صيانتها والحالة المذكورة فيها شيء من الصعوبة إذ إن الجدران تالفة ومتهرئة، والزخارف غير واضحة أو كاملة في أكثر من موضع مما تطلب قطع الأجزاء التالفة من الجدران، ثم حفر وسطها مع ترك الجوانب قائمة، ثم بناء الوسط وبشكل جيد ليكون أساساً يتحمل ما سوف يبنى عليه، مع المحافظة على وجهي الجدار بكسائه الجصي القديم وبشكل ينسجم واستمرارية البناء.
اما الزخارف غير الواضحة فكان مبدأ المقارنة والرجوع إلى الرسومات والصور عن الحفريات السابقة لهذه الدار، هو الأسلوب الوحيد في استكمال صيانة الزخارف الجصية.
ص: 320
ومنذ بداية شهر آذار 1982 بدأت أعمال الصيانة والترميم وبشكل مركز حيث شملت القسم الأكبر من غرف وأواوين وأروقة وزخارف هذه الدار، ويمكن أن نتناولها كما يلي: -
واجهة وكتلة المدخل الرئيس الذي توضحت معالمه خلال التنقيب كما أسلفنا، وتهيئة جدرانه ودكاكه للصيانة والترميم رفعت الأجزاء الهشة منها، ثم قطعت الأجزاء القوية منها بشكل متدرج لتسهل بذلك عملية تعشيق الجص مع الجدران والدكاك، وقد تمت صيانة الجزء البارز من كتلة المدخل إلى ارتفاع 1،5 متر وهو الارتفاع الأصل في البناء، ثم كانت المحافظة على طول هذا الجزء والذي كان حوالي 2 متر وهو الحقيقي للجزء البارز من كتلة المدخل سعة المدخل 1،5 متر فيها قليل من الانحراف نحو الشمال، كانت المحافظة على هذا الانحراف والكساء الجصي القديم للمدخل من أولى الأمور في صيانته والى ارتفاع مترين وهو الجزء المتبقي من ارتفاع جدرانه (لوح 19، 20).
وإلى يمين الداخل بعد اجتياز المجاز الثاني للمدخل تقع غرفة رقم 3 والتي كانت في حالة رديئة جداً بسبب تلف وتآكل جدرانها الا أن بعض ما بقي منها يكمل معالمها، وقد رفعت الأجزاء التالفة من الجدران وأعيد بدلها وبنفس القياسات والمواد بغية ربط الأجزاء القديمة من الجدران وتماسكها مع الأجزاء المعادة؛ لكسبها المتانة والقوة، والارتفاع بها إلى مستوى مترين.
ومنها إلى الغرفة رقم 4 التي تعرضت إلى تغيرات في البناء - كما أسلفنا - وقد راعينا هذه التغيرات أثناء الصيانة وميزنا بين الجدران الأصلية والجدران المضافة بارتفاع الأولى وانحفاض الثانية بمقدار 50 سم.
الغرف من (5- 8) تشكل الواجهة الشمالية المطلة على الساحة ( أ)، والتي ينفذ إليها بعد اجتياز المجاز الثاني من المدخل الرئيس مخطط رقم)، وواجهة هذه
ص: 321
الغرف مزينة بزخارف نباتية.
ولقد تمت صيانة هذه الغرف بما فيها الواجهة المزينة بالزخارف، حيث مليء مكان الأجزاء المفقودة من الزخرفة بمادة الجبس وقليل من الجص وبمستوى الأجزاء الباقية من الزخرفة أسفل الجدران (اي بثخن يتراوح 15 - 20سم)؛ وذلك لتكملتها بعد رسمها على الأجزاء المعادة من طبقة الجبس والجص ، ثم حفرها وبشكل ينسجم الجزء القديم من الزخرفة مع الجزء المعاد المكمل لها بالقياسات وأسلوب الحفر.
صيانة كتلة الغرفة المثمنة وما جاورها: -
ذكرنا سابقاً من ان بناء الغرفة المثمنة (18) وما جاورها (17) و (19) كان من مواد مختلفة، ولتراب فمن لبن جصي إلى خليط الجص التراب والحصى واللبن الطيني، وعند إجراء الصيانة لهذه الجدران أعيدت وفق مواصفات المواد المذكورة والى إرتفاع مترين الألواح (21) (22) (23).
ومن الجدير بالذكر إن الشركة الفرنسية اليف (ELF) وبرفقة أحد (1) منتسبي المؤسسة العامة أجرت محاولات تجارب لصيانة جدران اللبن الجصي للغرفة المثمنة باستعمال مادة (Etheyl Silicants) ، وذلك برش هذه المادة بواسطة فرشاة لدرجة تشبع الجدران بشكل جيد، وقد تركت هذه المادة على الجدار بما يقارب الشهرين.
وبعد الفحص الدقيق من قبل الشركة المذكورة لنتائج هذه التجربة توضح إن جدران اللبن الجصي امتصت المادة الكيمياوية وعبر مساماتها وأجزائها التالفة إلى عمق 5 سم وبذلك تماسكت الأجزاء التالفة وتصلبت مكونة بذلك قشرة صلبة تغلف أجزاء هشة من الجدران وبذلك يمكن القول إن الاستفادة سمكها 5سم من خصائص هذه المادة في تصلب جدران اللين الجصي وتقويتها بحيث تقاوم تأثير الطبيعة لا يتعدى الخمسة سنتمرات؛ وذلك لان قابلية الجص على امتصاص هذه
ص: 322
الصورة
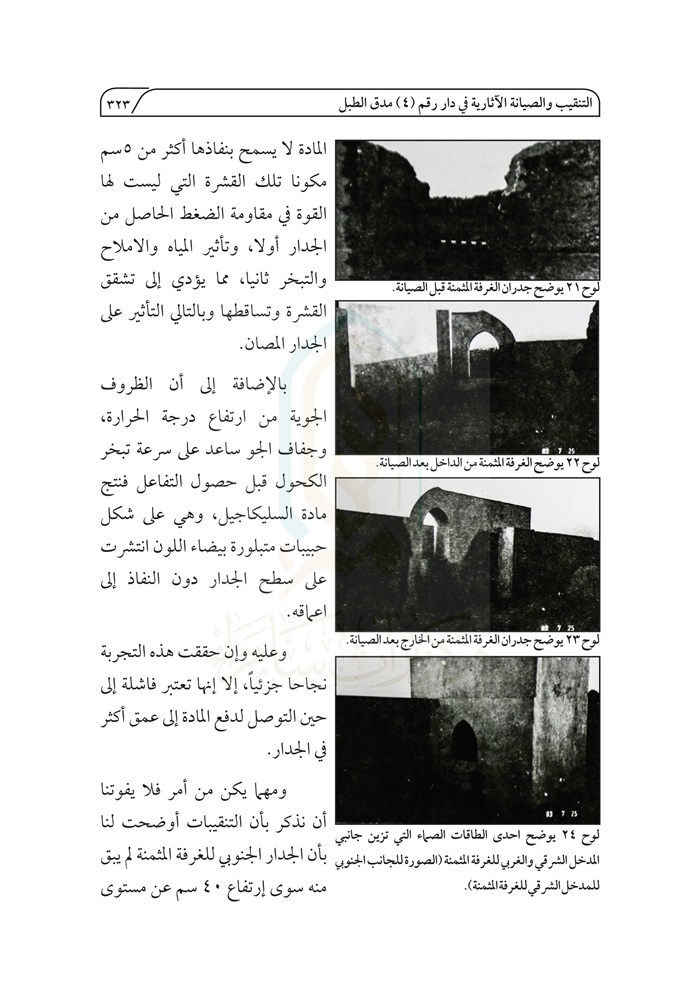
المادة لا يسمح بنفاذها أكثر من 5سم مكونا تلك القشرة التي ليست لها القوة في مقاومة الضغط الحاصل من الجدار أولا، وتأثير المياه والاملاح والتبخر ثانيا، مما يؤدي إلى تشقق القشرة وتساقطها وبالتالي التأثير على الجدار المصان.
بالإضافة إلى أن الظروف الجوية من ارتفاع درجة الحرارة، وجفاف الجو ساعد على سرعة تبخر الكحول قبل حصول التفاعل فنتج مادة السليكاجيل، وهي على شكل حبيبات متبلورة بيضاء اللون انتشرت على سطح الجدار دون النفاذ إلى اعماقه.
وعليه وإن حققت هذه التجربة نجاحا جزئياً ، إلا إنها تعتبر فاشلة إلى حين التوصل لدفع المادة إلى عمق أكثر في الجدار.
ومهما يكن من أمر فلا يفوتنا أن نذكر بأن التنقيبات أوضحت لنا للغرفة المثمنة لم يبق منه سوى إرتفاع 40 سم عن مستوى
ص: 323
الأرضية، في حين بقية جدران هذه الغرفة قائمة إلى ارتفاع مترين تقريبا، (لوح 21)، وعند البدء بصيانة هذا الجدار برزت أمامنا تساؤلات فيما إذا كان هناك مدخل أو نافذة في الجنوب؟ أو إن الجدار قائم كبقية الجدران من دون فتحة؟ وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أرضية الغرفة التي ترتفع عن مستوى أرضية الساحة (21) المجاورة من الجنوب بمقدار متر واحد استوجب أن يكون هناك سلم في الجهة الثانية من الجدار الجنوبي يؤدي إلى الساحة (21) إذا اعتبرنا هناك مدخلا (بابا)، إلا إن التنقيبات لم تستظهر مثل ذلك السلم (لوح 23)، مما جعلنا نستبعد احتمال وجود المدخل، فكانت فكرة النافذة أقرب إلى الحقيقة من المدخل إذ توضح لنا بعد التدقيق والمعاينة في الجزء المتبقي من الجدار الجنوبي لهذه الغرفة وجود ركن جدار ذي كساء جصي مما عزز وجود دخلة في الجدار، وعليه فقد عيدت هذه الدخلة كنافذة (لوح - 22) ذات عقد مرسوم من أربعة مراكز شبيهة بالطاقات الصماء التي تزين جانبي المدخل الشرقي والغربي لهذه الغرفة (لوح 24).
4 - صيانة الغرف من (92 - 23)
تشكل مجموعة الغرف هذه الواجهة الغربية المطلة على الساحة (9أ) والواجهة الشرقية المطلة على الساحة (45د) . الواجهة الغربية مزينة بزخارف نباتية ما تبقى منها في الركن الشمالي الغربي (لوح 36) من هذه الساحة لا يتجاوز ال_ (25سم)، ولكنها استكملت بالمقارنة مع زخارف الواجهة الشرقية والشمالية والجنوبية (لوح 35) من هذه الساحة والى ارتفاع متر واحد (الألواح 25، 26 ، 27).
5 - صيانة الغرف (64 - 25) (الألواح 82، 92)
تحتل مجموعة الغرف هذه الركن الشمالي الغربي من الدار، وعند البدء بصيانتها كان لا بد من قطع الأجزاء التالفة من الجدران ثم حفر الوسط إلى عمق يتراوح بين 50 سم و 75سم مع الاحتفاظ بجوانب الجدران قائمة، ثم بناء الوسط بشكل
ص: 324
جيد والارتفاع به إلى مستوى مترين، مع تهيئة أماكن الزخرفة بعد ملئها بمادة الجبس المخلوط بقليل من الجص.
6 - صيانة سور الدار من جهتي الشمال والشرق، والارتفاع به إلى مستوى مترين ونصف وبنفس مواصفات مواد البناء المستعملة بالأصل، وهي اللبن الجصي ذي القياس 30×730 سم والكتلة الممزوجة من الجص وقليل من التراب، ولقد أجريت تجارب لاختيار أنسب كتلة ممزوجة من المواد المذكورة كما في الجدول الآتي وكانت التجربة الأولى (أ) أنسب أو أصلح التجارب(1)، إذ إن الديسيمتر المكعب الواحد يتحمل ضغط (75) كيلو غراماً، بالإضافة إلى أن هذه الكتلة المضاف إليها محلول السيكا وضعت بالماء ولمدة ثلاثة أيام لمعرفة مقاومتها للرطوبة والمياه، فكانت النتيجة جيدة جدا.
7- ترميم وتكملة الزخارف الجصية:
الواقع انه عندما تتعرض أرضية الزخارف، أو ما يمكن تسميتها بطبقة الجص layer plaster ، للضغط الناشيء عن تبلور الأملاح، أو من جراء حركة المبنى نفسه، أو من تفاوت درجات الحرارة، فإنها تتشرح وتتشقق وربما تنفصل عن الجدران ذاتها، مما يؤدي إلى تساقط بعض أجزائها.
وعليه فقد كانت عمليات التقوية والترميم لهذه الزخارف تتم على النحو الآتي:
-أ- تحقن أرضية الزخارف من خلال الشروخ والشقوق بمستحلب من الجبس والماء بنسبة 1 : 5 ثم تترك فترة إلى أن تجف تماماً.
ب ترفع الأجزاء الآيلة للسقوط من الجدران مع المحافظة على أرضية الزخارف قائمة وتنظف ظهورها بالفرشاة، ثم تبنى الأجزاء التي رفعت من الجدار مع ترك فراغ (3 - 5 سم) بين الجدار والجزء القائم من الزخارف التي نظفت
ص: 325
ظهورها، ثم ملء الفراغ الحاصل بين الجدار وأرضية الزخارف بمستحلب الجبس والماء ويترك إلى أن يجف تماما؛ مما يؤدي إلى تماسك الأرضية مع الجدار بصورة جيدة، ثم تثبت أرضية بعض الأجزاء التي انفصلت، ثم تكملة الجزء المفقود من الزخارف بمادة الجبس المخلوط بالجص، ثم حفر الزخارف عليه بعد رسمها . (الألواح 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36)
ص: 326
المجلد الرابع والاربعون سنة 1986.
مهند عبد الوهاب نادر
امل عبد الرزاق قدوري
اولا: مقدمة تاريخية
عرفت سامراء ب_ (سر من رأى) (1)، وهي تقع إلى الشمال من بغداد، على بعد مئة وثلاثين كيلو متراً تقريباً، على الضفة اليمنى من نهر دجلة، وقد أسسها الخليفة العباسي المعتصم بالله (2) سنة 222 ه_ / 835م على قائدهِ أشناس. ونقل إليها مقر الحكم من بغداد. وقد حرص على أن يجعلها أعظم من عاصمة جده المنصور (3)، ورغب في أن يبرز معالمها في أسرع وقت ممكن، فأحضر المعتصم المهندسين فاختاروا مواضع القصور (4) ، ثم خطط القطائع للقواد والكتاب والناس، وخط المسجد الجامع، وخطط الأسواق حول المسجد الجامع، وجعلت كل تجارة منفردة، وكل قوم على حدتهم مثلما كان الحال عليه في أسواق بغداد(5).
ص: 327
وخطط شوارعها كأحسن ما تكون الشوارع سعة واستقامة وطولاً. وكتب إلى الأمصار فأتى عليه الفعلة والبناؤون والصناع المهرة من أهل المهن من الحدادين والنجارين وسائر الصناعات لمعالجة العمارة والزراعة وهندسة الماء واستنباطه وحمل إلى سامراء خشب الساج والرخام، ونقل إليها من سائر البقاع أنواع من الغروس والأشجار (1)، فارتفع البنيان وشيدت الدور والقصور وكثرت العمارة واستنبطت المياه.
وقد استعمل القوم ما بين أيديهم من المواد الخام، فمن الطين صنعوا اللبن والآجر (الطابوق)، ومن الأتربة الكلسية صهروا الجص الذي طلوا به الجدران التي تفننوا في زخرفتها، وقد خلدت الزخارف المختلفة - بعد أن اكتشفها الأثريون - اسم سامراء حتى اليوم (2) .
وقد سكن هذه العاصمة ثمانية خلفاء من بني العباس(3) كان آخرهم المعتمد الذي عاد مع بلاطه وحكومته إلى بغداد العاصمة القديمة، وما لبثت أن سقطت أبنية سامراء الواحدة تلو الاخرى، وظلت هيئة الإهمال حتى ازدانت به جدران عمائرها من زخارف محفورة على الجص وصور مرسومة بالألوان المائية (الفرسكو).
وتمتد أطلال سامراء مسافة خمسة وثلاثين كيلو متراً على شاطئ دجلة الشرقي، وتضم في بطونها قصور الخلفاء والأمراء والقادة، أطلالها تثير العجب والاندهاش، فقد كانت سامراء سيدة مدن العالم في العصور الوسطى. ولكن سامراء التي أذهلت العالم بظهورها أذهلته بدورها وخرابها. بعد أن رحل عنها الخليفة المعتمد على الله ونقل بلاطه إلى بغداد ثانية، وكان ذلك عام 276 ه_ / 889 م. وأصبحت سامراء
ص: 328
الصورة
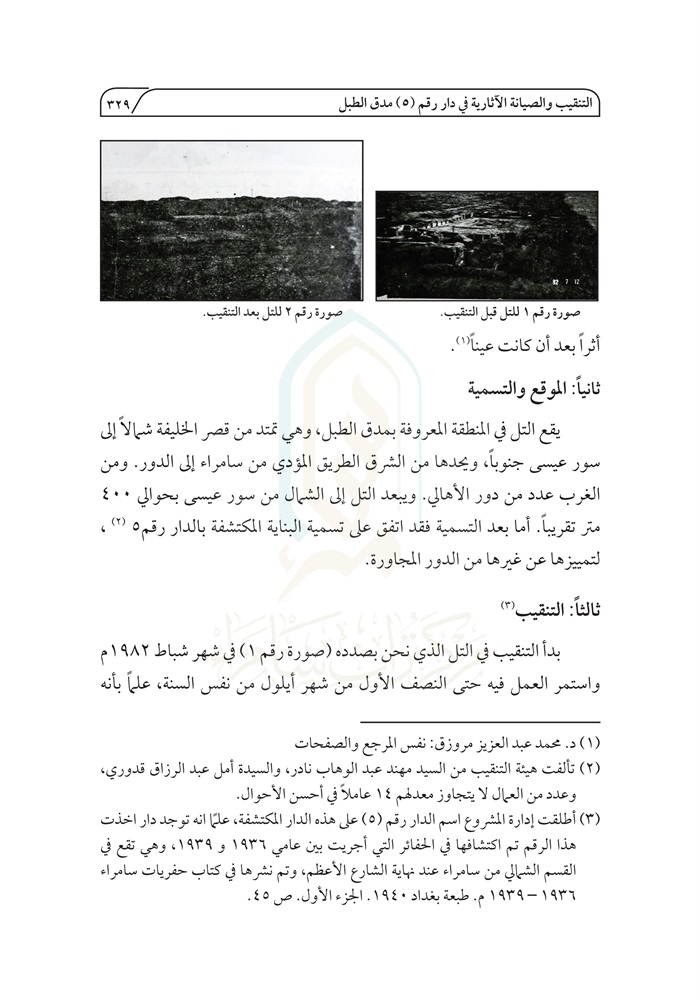
أثراً بعد أن كانت عيناً (1).
ثانياً: الموقع والتسمية
يقع التل في المنطقة المعروفة بمدق الطبل، وهي تمتد من قصر الخليفة شمالاً إلى سور عيسى جنوباً، ويحدها من الشرق الطريق المؤدي من سامراء إلى الدور. ومن الغرب عدد من دور الأهالي. ويبعد التل إلى الشمال من سور عيسى بحوالي 400 متر تقريباً. أما بعد التسمية فقد اتفق على تسمية البناية المكتشفة بالدار رقمه 5(2)، لتمييزها عن غيرها من الدور المجاورة.
ثالثاً: التنقيب(3)
بدأ التنقيب في التل الذي نحن بصدده (صورة رقم 1) في شهر شباط 1982م واستمر العمل فيه حتى النصف الأول من شهر أيلول من نفس السنة، علماً بأنه
ص: 329
الصورة
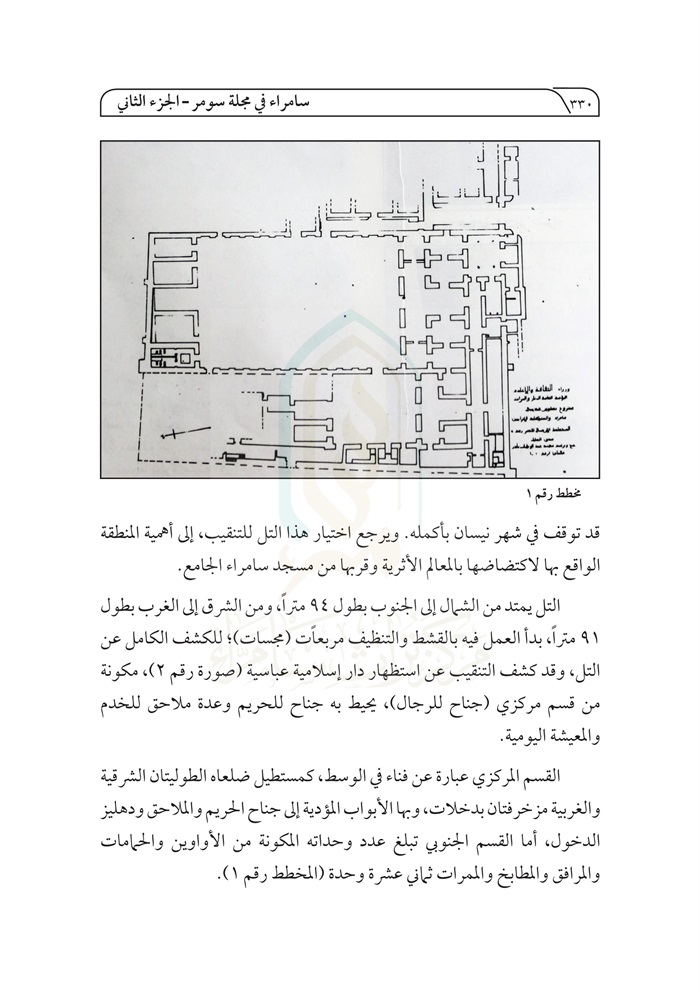
قد توقف في شهر نيسان بأكمله ويرجع اختيار هذا التل للتنقيب، إلى أهمية المنطقة الواقع بها لاكتضاضها بالمعالم الأثرية وقربها من مسجد سامراء الجامع.
التل يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 94 متراً، ومن الشرق إلى الغرب بطول 91 متراً، بدأ العمل فيه بالقشط والتنظيف مربعات (مجسات)؛ للكشف الكامل عن التل، وقد كشف التنقيب عن استظهار دار إسلامية عباسية (صورة رقم 2)، مكونة من قسم مركزي (جناح للرجال)، يحيط به جناح للحريم وعدة ملاحق للخدم والمعيشة اليومية.
القسم المركزي عبارة عن فناء في الوسط، كمستطيل ضلعاه الطوليتان الشرقية والغربية مزخرفتان بدخلات، وبها الأبواب المؤدية إلى جناح الحريم والملاحق ودهليز الدخول، أما القسم الجنوبي تبلغ عدد وحداته المكونة من الأواوين والحمامات والمرافق والمطابخ والممرات ثماني عشرة وحدة (المخطط رقم 1).
ص: 330
جناح الحريم والملاحق التي على الجانبين التي تم الكشف عنها حتى الآن تتصل بالقسم المركزي بواسطة أبواب وفتحات تبدو أحياناً أنها أوجدت بعد إتمام البناء لأسباب ربما تكون اجتماعية، مثل توسع العائلة، مع ضرورة المحافظة على سهولة الاتصال للإبقاء على الرابطة العائلية القوية (1):
الصورة
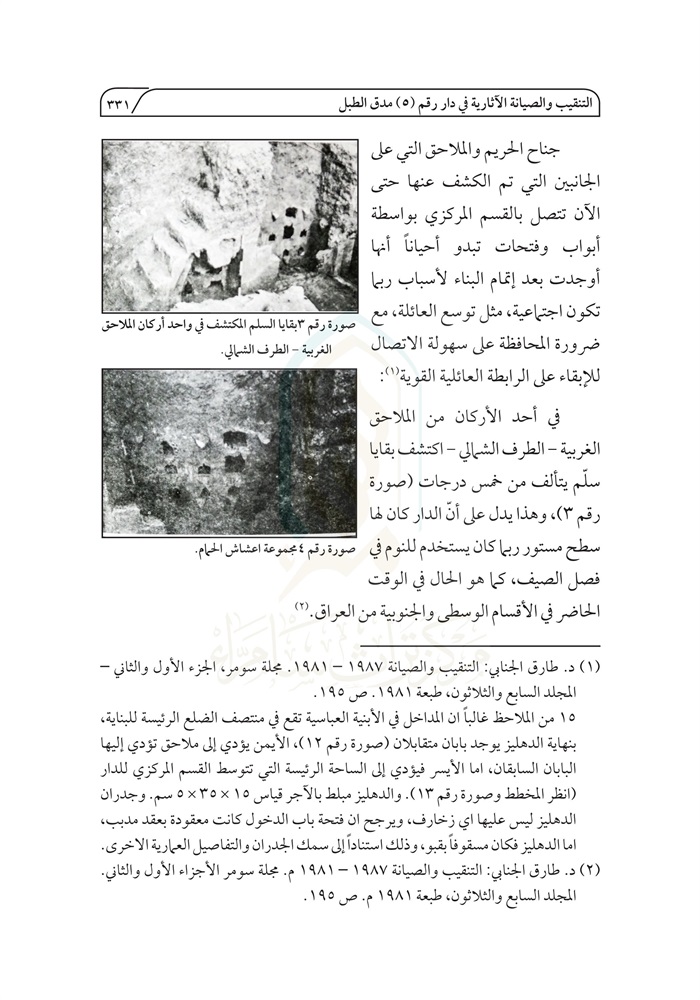
في أحد الأركان من الملاحق الغربية - الطرف الشمالي - اكتشف بقايا سلّم يتألف من خمس درجات (صورة رقم 3)، وهذا يدل على أنّ الدار كان لها سطح مستور ربما كان يستخدم للنوم في فصل الصيف، كما هو الحال في الوقت الحاضر في الأقسام الوسطى والجنوبية من العراق. (2)
ص: 331
الصورة
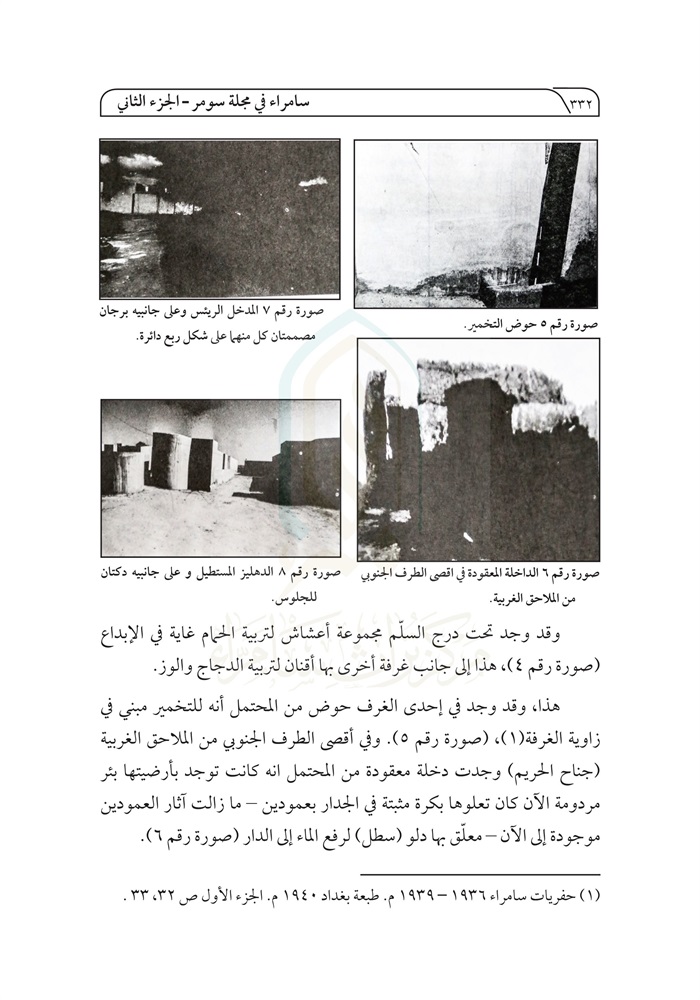
وقد وجد تحت درج السلّم مجموعة أعشاش لتربية الحمام غاية في الإبداع (صورة رقم 4 ) ، هذا إلى جانب غرفة أخرى بها أقنان لتربية الدجاج والوز.
هذا، وقد وجد في إحدى الغرف حوض من المحتمل أنه للتخمير مبني في زاوية الغرفة (1)، (صورة رقم 5). وفي أقصى الطرف الجنوبي من الملاحق الغربية جناح الحريم وجدت دخلة معقودة من المحتمل انه كانت توجد بأرضيتها بئر مردومة الآن كان تعلوها بكرة مثبتة في الجدار بعمودين - ما زالت آثار العمودين موجودة إلى الآن - معلّق بها دلو (سطل) لرفع الماء إلى الدار (صورة رقم 6).
ص: 332
استعمل اللبن للبناء والجص مادة رابطة جدران بعض الوحدات مسیح بالجص ، والبعض الآخر يعلوه زخارف جصية من زخارف الطراز الثالث - التي نفذت بطريقة الحفر المشظوف - كما أن أرضيات الوحدات ودهليز المدخل الرئيس وأجزاء من الساحة التي تتوسط جناح الرجال، والساحة التي تتوسط جناح الحريم مبلطة بالطابوق الفرشي مقياس 50 ×50 × 5 سم ، وكذلك 25 × 25 × 5 سم. الجدران الخارجية لهذه البناية بحدود 25 1 متراً، أما الجدران الداخلية بحدود 121 متراً، والمتبقي من هذه الجدران ارتفاعه يتراوح بين 25 سم و 2 متر.
وقد عثر في الدفن أثناء التنقيب على أجزاء من أوان خزفية ذات بريق معدني، وأجزاء من جرار وأوان فخارية، وبعض القناني الزجاجية وأجزاء منها، وإناء كبير من الجص هذا إلى جانب قطع صغيرة من الخشب عليها زخارف مائية بحالة رديئة وقطعة من الرخام الأبيض المعرق عليها كتابة سنأتي على ذكر تفاصيلها لاحقاً.
رابعاً: التوصيف العماري:
يضم التل في باطنه بيتاً إسلامياً لم تكشف التنقيبات في الموسم الأول الا عن أجزاء منه، سوف نتناولها بالتوصيف.
1 - كتلة المدخل:
(انظر المخطط / 1 ) يقع المدخل الرئيس في منتصف الواجهة الجنوبية تقريباً(1)، على جانبيه برجان مصحتان يأخذ كل منها شكل 1/ 4 دائرة (صورة رقم 7)، المسافة بين البرجين 50، 5 متراً، والعمق حتى باب الدخول 50 ، 1 متراً، (حجر المدخل)، یلي ذلك فتحة باب الدخول سعتها 30 ، 3 متراً. من باب الدخول تصل إلى دهليز مستطيل طوله 60، 14 متراً وعرضه 5 أمتار. على جانبيه دكتان للجلوس بعرض90 سم وارتفاع 70 سم عن مستوى الأرض (صورة رقم 8)، في نهايته على يمين
ص: 333
الصورة
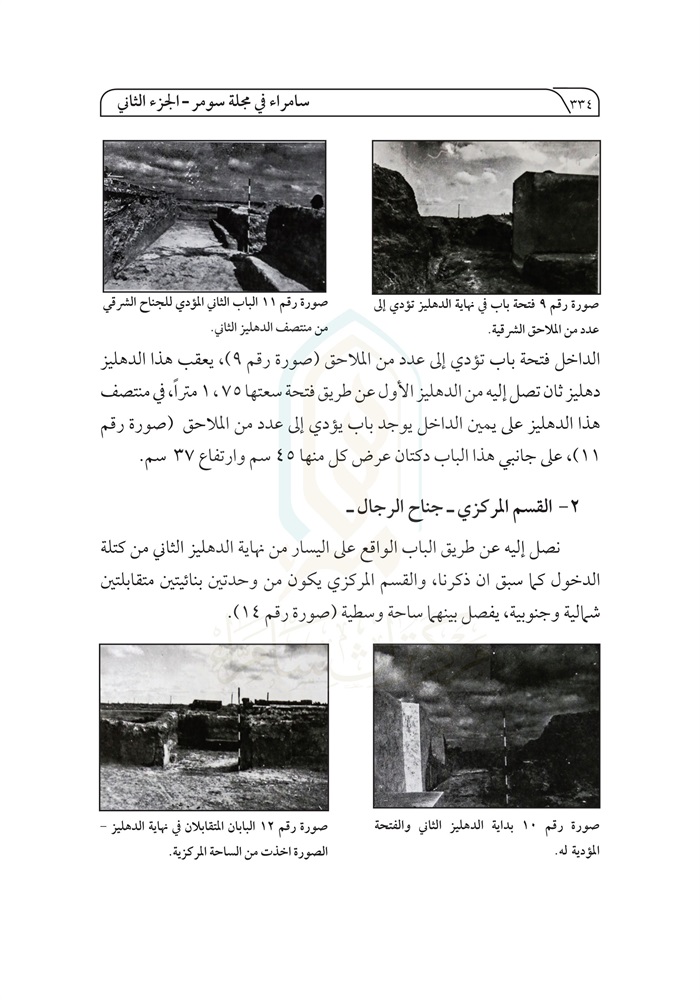
الداخل فتحة باب تؤدي إلى عدد من الملاحق (صورة رقم 9) ، يعقب هذا الدهليز دهليز ثان تصل إليه من الدهليز الأول عن طريق فتحة سعتها 1،75 متراً، في منتصف هذا الدهليز على يمين الداخل يوجد باب يؤدي إلى عدد من الملاحق ( صورة رقم 11)، على جانبي هذا الباب دكتان عرض كل منها 45 45سم وارتفاع 37 سم.
2 - القسم المركزي - جناح الرجال -
نصل إليه عن طريق الباب الواقع على اليسار من نهاية الدهليز الثاني من كتلة الدخول كما سبق ان ذكرنا والقسم المركزي يكون من وحدتين بنائيتين متقابلتين شمالية وجنوبية، يفصل بينهما ساحة وسطية (صورة رقم 14).
ص: 334
الصورة
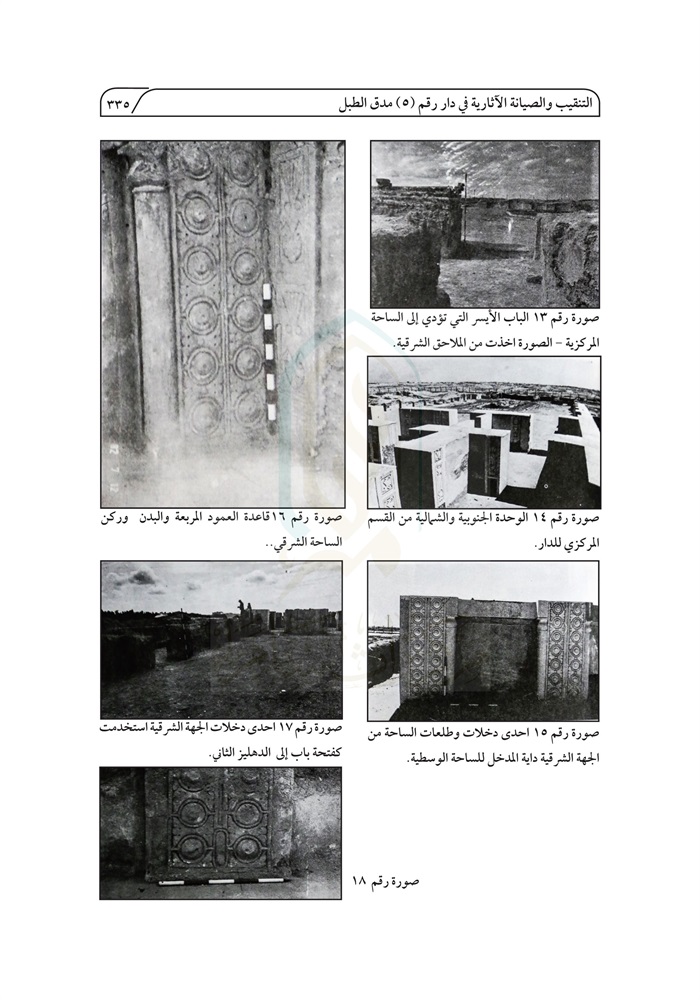
صورة رقم 13 الباب الأيسر التي تؤدي إلى الساحة المركزية - الصورة اخذت من الملاحق الشرقية.
صورة رقم 14 الوحدة الجنوبية والشمالية من القسم المركزي للدار.
صورة رقم 15 احدى دخلات وطلعات الساحة من الجهة الشرقية داية المدخل للساحة الوسطية.
صورة رقم 16 قاعدة العمود المربعة والبدن وركن الساحة الشرقي.
صورة رقم 17 احدى دخلات الجهة الشرقية استخدمت كفتحة باب إلى الدهليز الثاني.
صورة رقم 18
ص: 335
أ- الساحة الوسطى
مستطيلة الشكل طولها 38,50 متراً وعرضها 25 مترا،ً الضلعان الطوليتان الشرقية والغربية بهما دخلات عدد دخلات، كل جانب 13 دخلة، سعة كل دخلة 75، 1 متراً، على جانبي كل دخلة (صورة رقم 15) عمودان، قاعدة العمود مربعة بطول 20 × 20 سم، ويعلو بدن العمود (صورة 16) البالغ طوله 1،50 متراً تاج إسلامي روماني الشكل كان يتوج كل دخلة عقد مدبب ترتكز رجلاه على تاجي عمود الدخلة.
وقد استغلت بعض الدخلات كفتحات أبواب (صورة رقم 17) تؤدي إلى الملاحق الكائنة في الجهتين الشرقية والغربية للقسم المركزي، إذ يلاحظ بالجانب الشرقي 3 أبواب الجنوبي منها يؤدي إلى دهليز المدخل. أما الضلع الغربية ففيها .بابان والدخلات خالية من الزخرفة غير إن المساحة المحصورة بين كل عمودين من الخارج (الطلعة) مزخرفة بزخارف جصية منفذة بشكل بديع جداً، حيث ظهر ثلاثة أشكال هندسة مختلفة.
(16) الطراز الثالث: في الطراز ازداد ابتعاد الفنان عن الطبيعة ازدياداً جلياً، غير انه كان لهذا الطراز طابع خاص في مظهره يميزه بسهولة عن جميع الطرز الزخرفية السابقة عليه إسلامية كانت أم غير إسلامية، ذلك إن الفنان المسلم استخدم في عمل الزخرفة طريقة جديدة لم تكن معرفة من قبل، وهي المعروفة انها متشابهة بالمضمون - (صورة رقم 18) 19 و 20 ، الساحة ما زالت تحتفظ بممشى مبلط بالطابوق الفرشي قياس 50× 50 × 5 سم بعرض 10، 2 متراً من الجهات الأربع. أما وسط الساحة فترك بدون تبليط؛ لأنه كان يستخدم في الغالب لغرس الأشجار والورود التي تضفي منظراً جمالياً على داخل الدار بالإضافة إلى تنقية الهواء، وأحياناً كانت توجد نافورة في وسط الساحة، غير انه بعد التحري الأثري لم نجد أثراً لنافورة .
ص: 336
ب - الوحدة الشمالية
تتكون من إيوان طوله 50 ، 7 متراً وعرضه 40، 4 مترًا، على جانبيه غرفتان طول كل منهما 40 ، 7 متراً وعرضها 70 ، 4 متراً ، الإيوان والغرفتان أرضيتهما مبلطة بالطابوق الفرشي مقاس 30 × 30 × 5 سم. وظهر أسفل ذلك تبليط آخر من الطابوق الفرشي مما يدل على أنه تحديد قد حدث في الدار بطريقة الحفر المشطوف أو الحفر المائلcut slant بدلاً من طريقة الحفر العميق التي كانت تابعة. وقد جاء اهتداؤه إلى هذه الطريقة الجديدة من استعمال MouldS .
ويلاحظ هنا أن الإيوان والغرفة الغربية الملاصقة له قد أضاف المعمار لهما جدار ثانٍ في الناحية الشمالية؛ وذلك لكي تكون أركانها زوايا قائمة (1 انظر المخطط رقم 1)، على جانبي الغرفتين السابقتين غرفتان أخريان الشرقية طولها 8،50 متراً وعرضها 70، 7 متراً، أما الغربية فطولها 30، 7 متراً وعرضها 70، 3 متراً، هي بمثابة مرافق تحتوي على مرحاض وحمام (صورة رقم 21) الوحدة كلها تطل مباشرة على الساحة الوسطى دون رواق يتقدمها، وهذا التكوين هو ما يسمى بالنظام الحيري البسيط.
ج- الوحدة الجنوبية
الواجهة المطلة على الساحة مزخرفة، ويتضمن خمس فتحات (صورة رقم 22) على جانبي كل فتحة عضادة مزخرفة بزخارف نباتية تتصل بالزخرفة الجصية (صورة رقم 23)، وتتكون هذه الوحدة (انظر المخطط رقم 1) من إيوان (الصدر) طوله 40 ، 7 متراً وعرضه 0، 5 متراً ، جدارية يعلوها زخرفة جصية تتبع الطراز الثالث، والارتفاع 10 ، 1 متر تقريباً (صورة رقم 24)، على جانبيه غرفتان (الكمين) متساويتان طول كل منهما 20، 6 متر وعرضها 20، 4 متر، على جانبي هاتين الغرفتين غرفتان أخريان متساويتان في المساحة طول كل منهما 20، 6 متراً وعرضها 70 3 متر بالضلع الغربية للغرفة الغربية باب نصل منه إلى الملاحق
ص: 337
الصورة
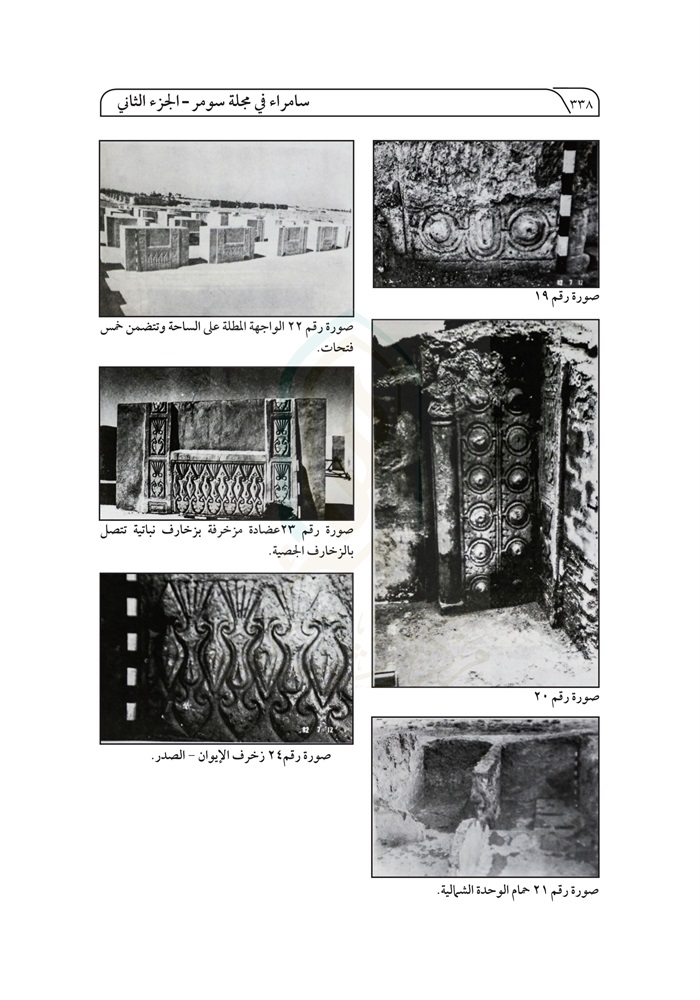
ص: 338
الصورة

الغربية، وبالضلع الشمالية مشكاتان صغيرتان ( صورة رقم 25)، وبالضلع الشرقية للغرفة الشرقية باب يؤدي إلى الدهليز الأول لكتلة الدخول، غير انه جزء منه مسدود؛ لأن جدران الغرفة الأربعة يعلوها زخارف جصية مثل الإيوان لارتفاع 10، 1 متراً تقريباً (صورة رقم 26)، أرضيات الإيوان والغرف الأربع مبلطة بالطابوق الفرشي مقاس 30×30 × 5سم.
يتقدم الإيوان والغرف الأربع التي على جانبيه رواق طوله 15 متراً وعرضه 10 ، 4 متراً، يطل على الساحة الوسطى باتكة خماسية عقودها مندثرة الان أوسع عقودها العقد الوسط المواجه للإيوان لبيان أهميته، ما ما يعرف بالطراز الحيري المركب غير انه اقتطع في فترة لاحقة من الرواق من طرفه الشرقي والغربي غرفتان أُحدثتا بواسطة جدارين، يتوسط كل منهما فتحة (باب) (صورة رقم 26 أيضاً)، الغرفة الشرقية طولها 30، 4 متراً، وعرضها 10 ، 4 متراً، والغرفة الغربية طولها 80 ، 4 متراً وعرضها 10 ، 4 متراً، والغرفة الغربية طولها 80 ، 4 متراً وعرضها 4 ، 10 متراً (انظر المخطط رقم 1).
ص: 339
3- الملاحق الخلفية للوحدة الجنوبية
الملاحق الخلفية لهذا القسم عبارة عن قاعدة طولها 7،50 متراً وعرضها 10، 6 متراً، بها 4 دعامات مربعة. طول ضلع الدعامة 45 سم (صورة رقم 27)، وذلك لحمل السقف الذي كان غالباً مسطحاً. يفتح على القاعة إيوان طوله 3،60 متراً وعرضه 30 ، 2 متراً ( صورة رقم 28)، كان يطل على القاعة بعقد مدبب ولكن قمئ لان رجل العقد الباقية (صورة رقم 29 و 30) لا تبتدئ من أعلى الجدار، ولكنها تبتدئ من منتصف الجدار تقريباً، ربما قصد بذلك الا يرتفع عن السقف المسطح
الصورة
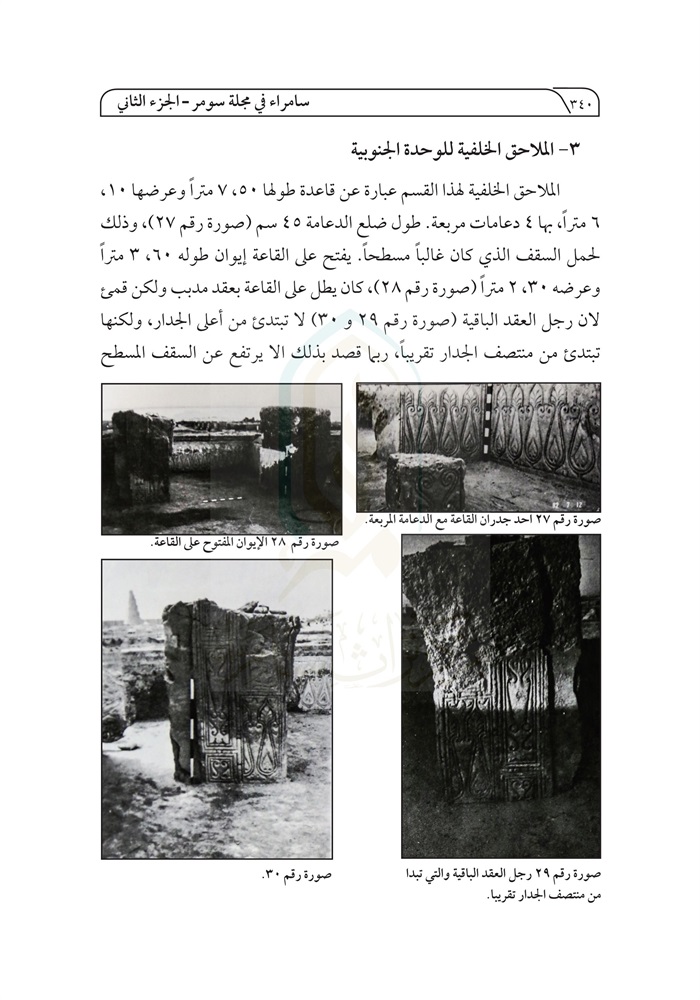
ص: 340
الصورة
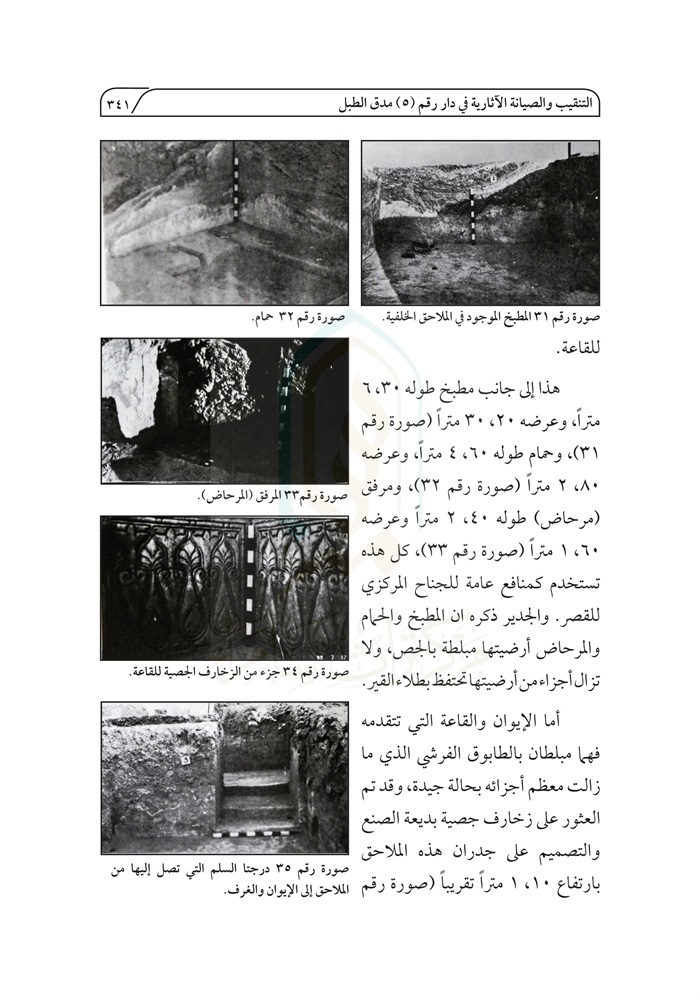
للقاعة.
هذا إلى جانب مطبخ طوله 30، 6 متراً، وعرضه 20 ، 30 متراً (صورة رقم 31)، وحمام طوله 60، 4 متراً، وعرضه 80، 2 متراً (صورة رقم 32)، ومرفق (مرحاض) طوله 2،40 متراً وعرضه 60، 1 متراً (صورة رقم 33)، كل هذه تستخدم كمنافع عامة للجناح المركزي للقصر. والجدير ذكره ان المطبخ والحمام والمرحاض أرضيتها مبلطة بالجص، ولا تزال أجزاء من أرضيتها تحتفظ بطلاء القير.
أما الإيوان والقاعة التي تتقدمه فهما مبلطان بالطابوق الفرشي الذي ما زالت معظم أجزائه بحالة جيدة، وقد تم العثور على زخارف جصية بديعة الصنع والتصميم على جدران هذه الملاحق بارتفاع 10 ، 1 متراً تقريباً (صورة رقم
ص: 341
34) ، هذه الملاحق مثبتة على مستوى منخفض عن أرضية الإيوان والغرفة التي على جانبيه، لذا نصل بينهما عن طريق درجتي سلّم (صورة 35).
4 - جناح الحريم
يقع إلى الغرب من القسم المركزي (جناح الرجال)، وتصل إليه عن طريق بابين أحدهما بالطرف الجنوبي من الضلع الغربية للساحة الوسط من القسم المركزي. والثاني في منتصف الضلع الغربية للغرفة التي على يسار الكم الغربي للإيوان الرئيس من القسم المركزي.
وهذا الجناح يتكون من:
ساحة وسطى طولها 150 متراً وعرضها 130 متراً، مبلطة بعرض 10 ، 2 متراً من الجهات الأربع بالطابوق الفرشي مقاس 50×50×5 سم. أما الوسط فترك بدون تبليط.
يحيط بالساحة من الناحية الجنوبية إيوان طوله الناحية الجنوبية إيوان طوله 50 ، 5 متر وعرضه 70، 3 متراً، على جانبي فتحة الإيوان (4) أعمدة مدمجة، اثنان في كل جانب - بقصد إضفاء ناحية جمالية زخرفية ( صورة رقم(36 و 37)، أرضية الإيوان مبلطة بالطابوق الفرشي وجدرانه مزخرفة بزخارف جصية من الطراز الثالث لارتفاع 10 ، 1 متراً (صورة رقم 38)، على جانبي الإيوان غرفتان اليسرى الكم) الايسر) طولها 50، 4 متراً عرضها 80، 3، بضلعها الجنوبية مشكاوان يتوج كلاً منهما عقد مدبب، يعلو أحدهما ورقة نباتية مدببة (صورة رقم 39) وارضية الغرفتين مبلطة بالطابوق الفرشي وهي خالية من الزخرفة يتقدم الإيوان والغرفتين (الكمين) رواق طوله 130 متراً وعرضه 30 ، 3 متراً، أرضيته مبلطة بالطابوق الفرشي وجدرانه يعلوها زخارف جصية بارتفاع متر واحد تقريباً، يطل الرواق على الساحة ببائكة ثلاثية عقودها الان أوسعها العقد الأوسط لبيان أهمية الإيوان، وهذا ما يعرف - كما سبق أن ذكرنا -
ص: 342
بالطراز الحيري المركب.
أما من الناحية الشمالية للساحة فالمكتشف إيوان طوله 60 متراً وعرضه 50، 3 أمتار، سعة فتحته المطلة على الساحة 3 أمتار لوجود كتفين عرض كل منهما 25 سم (صورة رقم 40) ، أرضيته مبلطة بالطابوق الفرشي وجدرانه مزخرفة بالزخارف الجصية المنفذة بالأسلوب الثالث ( صورة رقم 41 )، يتصل بهذا الإيوان من الجهة الشمالية غرفة طولها 4,20 متراً وعرضها 3 متراً، وذلك عن طريق باب سعته متر واحد نصل عن طريقه إلى غرفة لم يتم الكشف سوى عن جزء منها، بها عدة أقنان (دخلات) كبيرة، يبدو أنها كانت مخصصة لتربية الطيور والدجاج والإوز (صورة رقم 42 )، على الجانب الغربي من الإيوان غرفة طولها 150، 6 متراً وعرضها 85، 2 متراً، مدخلها المطل على الساحة سعته متر واحد أرضيتها مبلطة بالجص ، وهي خالية من الزخرفة .
الصورة

ص: 343
الصورة
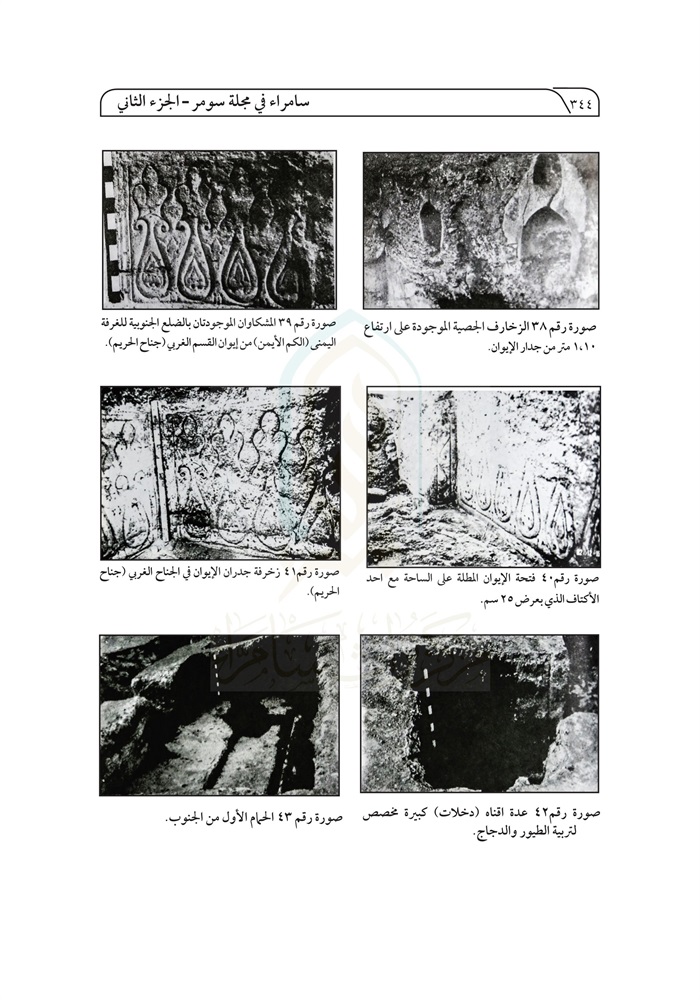
صورة رقم 38 الزخارف الجصية الموجودة على ارتفاع1،10 متر من جدار الإيوان.
صورة رقم 39 المشكاوان الموجودتان بالضلع الجنوبية للغرفة اليمنى (الکلم الأيمن) من إيوان القسم الغربي (جناح الحريم).
صورة رقم 40 فتحة الإيوان المطلة على الساحة مع احد الأكتاف الذي بعرض 25 سم .
صورة رقم 41 زخرفة جدران الإيوان في الجناح الغربي (جناح الحريم).
صورة رقم 42 عدة اقناه (دخلات) كبيرة مخصص لتربية الطيور والدجاج.
صورة رقم 43 الحمام الأول من الجنوب.
ص: 344
الصورة
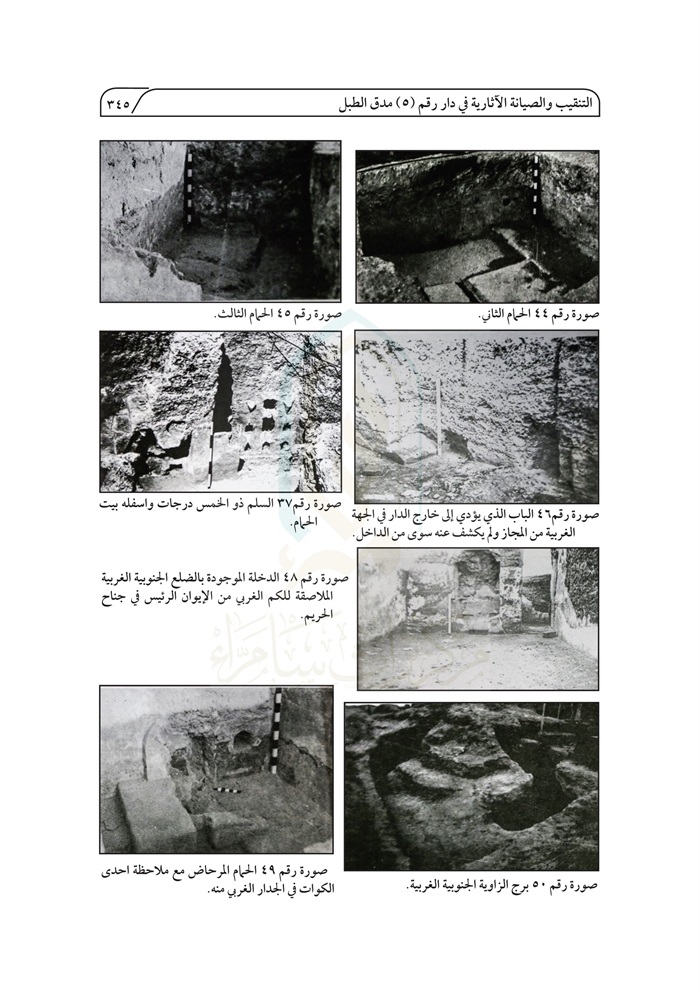
صورة رقم 44 الحمام الثاني.
صورة رقم 45 الحمام الثالث.
صورة رقم 46 الباب الذي يؤدي إلى خارج الدار في الجهة الغربية من المجاز ولم يكشف عنه سوى من الداخل.
صورة رقم 37 السلم ذو الخمس درجات واسفله بيت الحمام.
صورة رقم 48 الدخلة الموجودة بالضلع الجنوبية الغربية الملاصقة للكم الغربي من الإيوان الرئيس في جناح الحريم.
صورة رقم 50 برج الزاوية الجنوبية الغربية.
صورة رقم 49 الحمام المرحاض مع ملاحظة احدى الكوات في الجدار الغربي منه.
ص: 345
اما على الجانب الشرقي للإيوان فما زالت الأتربة حيث لم يتم التنقيب فيه، ولكن يبدو أنها غرفة مماثلة للغرفة الغربية، وهذا القسم لا يتقدمه بائكة، وهو المعروف بالحيري البسيط.
الجانب الشرقي من الساحة ليس به أي بنايات ولكن يتوسطه الباب الرابط بينها وبين ساحة القسم المركزي.
أما الجانب الغربي ففيه ثلاثة حمامات (صورة رقم 43 و 44 و 45)، الأول من الجنوب طوله 20 ، 3 متراً عرضه 90، 2 متراً، والثاني طوله 3،70 متراً وعرضه 90 ، 2 متراً، والثالث طوله 60 ، 5 متراً وعرضه 90 ، 2 متراً، لكل حمام باب يطل على الساحة سعته 10 ، 1 متراً، أرضيتها مبلطة بالجص Mortar والجدران خالية من الزخرفة مجاري هذه الحمامات متصلة بعضها بالبعض لتصريف المياه.
في أقصى الطرف الشمالي لهذا الجانب فتحة باب سعته 20، 1 متر، تؤدي إلى مجاز طوله 90، 12 متراً وعرضه 60 ، 2 متراً، بالجانب الغربي لهذا المجاز باب يؤدي إلى خارج الدار من هذه الجهة تم الكشف عنه من داخل المجاز فقط سعته 60، 1 متراً ( صورة رقم 46) ، بنهايته 5 درجات سم كما سبق الذكر، كانت تؤدي إلى طابق علوي، أسفل الدرج ب جميل للحمام (صورة رقم 47) زخرفت واجهات دخلاته (الأعشاش ) بأحجية جصية على هيئة عقود مدببة أو مستديرة أو ورقة نباتية، أرضية المخازن سالفا الذكر مبلطة بالجص وجدرانها خالية من الزخرفة.
أما الجزء الواقع خلف ذلك فلم يتم التنقيب فيه بعد، إلى الغرب من الغرفة الغربية المجاورة للإيوان الرئيس والرواق الذي أمامه غرفة طولها ، 9 متراً وعرضها 20 ، 3 متراً، نصل إليها عن طريق باب الضلع الغربية للرواق، بمنتصف ضلعها الجنوبية دخلة متوّجة بعقد (صورة رقم 48) ، يبدو انه كان بأرضيتها بئر مياه cistern تعلوها بكرة محمولة على عمودين - ما زالت آثارهما موجودة - مربوط بها
ص: 346
دلو لرفع المياه إلى أهل الدار ، أو ربما مزملة (مكان لوضع الحباب) للشرب، الغرفة مبلطة بالطابوق الفرشي ، وجدرانها ليست مزخرفة.
إلى الخلف من جناح الرجال وجناح الحريم ممر طوله 50، 31 متراً وعرضه 30، 2 متراً، مقسّم بواسطة باب إلى قسمين يفصل جناح الرجال عن جناح الحريم، بطرفه الغربي أوجدت غرفة محدثة طولها 50 ، 2 متراً وعرضها 2،40 مترًا، لها باب في منتصف ضلعها الشرقية بنهاية الطرف الشرقي للممر باب يؤدي إلى القاعة السالفة الذكر، والجانب الشمالي من الممر به (4) أبواب اثنان يؤديان إلى إيوان القسم المركزي والغرفة التي على يساره والبابان الآخران أحدهما يؤدي إلى إيوان جناح الحريم، والثاني إلى الغرفة التي بها البئر أو المزملة.
والجانب الغربي به (4) أبواب كذلك، الأول من الغرب يؤدي إلى غرفة طولها 80،5 متراً وعرضها 70، 2 متراً، مقسمة إلى قسمين بواسطة جدار محدث بطرفه الشمالي فتحة باب بسعة 70 سم، القسم الأول طوله 30، 3 متراً وعرضه 70، 2 مترا، يتصدره دكة بعرض 50 ، 1 متراً؛ أما القسم الثاني طوله 70، 2 متراً وعرضه ه، 2 متراً، استخدم كحمام ومرحاض (صورة رقم 49)، وبالجدار الغربي لهذا القسم عدة كوات، ومن الملاحظ انهم استعملوا جراراً فخارية مع البناء مفتوحة من الجهتين كهوائي للتنفيس، الباب الثاني يؤدي إلى غرفة كبيرة طولها (18) متراً وعرضها 2،80 متراً كانت في السابق عبارة عن (4) غرف كل منها لها باب يفتح على الممر غير إنه أزيلت جدران الغرف وسدّت ثلاثة أبواب من الأربعة وبقي باب واحد، الباب الثالث يؤدي إلى غرفة طولها 80، 3 متراً وعرضها 2،60 مترا، بالركن الشمالي حوض تخمير (انظر صورة رقم 5 سابقاً)، نصل من هذه الغرفة عن طريق باب بضلعها الجنوبية بدرجتي سلم (انظر صورة رقم 35 سابقاً) إلى غرفة أخرى طولها 40، 2 متراً وعرضها 90، 1 متراً، أما الباب الرابع فيؤدي إلى المطبخ الذي يفتح على القاعة.
ص: 347
5 - الجناح الشرقي
نصل إليه عن طريق خمسة أبواب أحداها في نهاية الدهليز الأول من كتلة الدخول (انظر صورة رقم 9) وبابان في الدهليز الثاني لكتلة الدخول (صورة رقم 11 و )12، والبابان الآخران لم يتم الكشف سوى عن بعض جدران لا تمثل سوى أجزاء من غرف، ولهذا لا نستطيع الحديث عن هذا القسم وسوف نرجئه إلى حينه بعد التنقيب في هذا الجزء.
رابعاً: التحصينات الخارجية
الدار كانت محصنة من الخارج بأبراج ركنية ووسطية مصمتة Massive حيث تم الكشف في الزاوية الجنوبية الغربية عن برج ناصية مربع (صورة رقم 50) ، كما عثر في الجهة الغربية من الجانب الأيسر من كتلة الدخول على برج مربع (صورة رقم 51)، ولم نستطع الآن حصر عدد الأبراج الوسطية إلى جانب أبراج النواصي الأربع؛ لأنه لم يتم الكشف تماماً عن الدار، وهذه الأبراج المصمتة كانت تستخدم كدعامات ساندة Buttress للجدران الخارجية، وليست لسبب آخر .
خامساً: الصيانة
توقف التنقيب نهاية النصف الأول من شهر أيلول 1982م، ومع بداية النصف الثاني من الشهر نفسه بدأت أعمال الصيانة للأجزاء التي تم الكشف عنها خوفاً من تأثرها بمياه الأمطار والعوامل الجوية، ونظراً لانتهاء طبيعة العمل في المشروع فقد توقفت الصيانة مع بداية شهر ايار 1983م، مما جعلنا لا نتمكن من صيانة كافة الأجزاء المكتشفة.
وقد بدأت الصيانة بالارتفاع بالجدران إلى مستوى يتراوح بين 25، 1 متر، و 2 مترين، سبق أن ذكرنا عند الحديث عن التنقيب أن أقل ارتفاع للجدران تم الكشف
ص: 348
عنه 25 سم، وأعلى ارتفاع 2 متر، وقد استخدم في البناء اللبن والجص كمادة رابطة، وهي مواد البناء الأصلية، فقد تم لنا صيانة كتلة المدخل ببناء جدرانها باللبن والجص لارتفاع 50 ، 1 متراً، وبناء الدكاك الثلاث الموجودة بها، ولبخ جدران كتلة المدخل والدكاك بالجص ( صورة رقم 7 و 8) ، وفي الساحة المركزية للقسم الرئيس تم صيانة الدخلات الأربع الموجودة بالطرف الجنوبي من الضلع الشرقية والزخارف المحصورة بين هذه الدخلات وهي عبارة عن زخارف هندسية قوامها دوائر متداخلة متتالية منفذة باسلوب سامراء الثالث (صورة رقم 15) ، وأيضاً تم صيانة الدخلة الواقعة في الطرف الجنوبي من الضلع الغربية للساحة.
كما تم صيانة واجهة البائكة الخماسية المطلة على الساحة والتي تتقدم الإيوان الرئيس والغرف الأربع التي على جانبيه وإعادة زخارفها المتآكلة إلى ما كانت عليه سابقاً بارتفاع يتراوح بين 10 ، 1 متراً و 2 مترين، أما الأجزاء الخالية من الزخرفة فتم لبخها بالجص (صورة 22).
كذلك تم صيانة جدران الإيوان الرئيس والغرف الأربع التي على جانبيه والملاحق الواقعة خلف ذلك الإيوان، المكونة من القاعة والحمام والمرحاض والمطبخ حيث ارتفع بالجدران إلى مستوى 2 مترين وإعادة زخرفة الإيوان وجميع جدران الغرف والملاحق التي كانت بها زخارف سابقاً، وهي عبارة عن زخارف نباتية منفذة بالأسلوب السابق وهي ترتفع عن أرضية الغرف بحوالي 10 ، 1 متراً تقريباً. أما الأجزاء الخالية من الزخرفة فقد تم لبخها بالجص (صورة رقم 14 و 25 و 29)، أما بالنسبة للقسم الغربي من الواجهة الجنوبية الذي يقع على يسار باب كتلة الدخول فقد تم صيانة أكثر من نصفه وإعادة بناء أحد الأبراج الوسطية (صورة رقم 51) وذلك إلى ارتفاع 25 ، 1 متراً.
هذا وقد تم لبخ أعلى الأجزاء المصانة بالجص الممزوج بمادة السيكا حفاظاً عليها من الرطوبة .
ص: 349
سادساً: اللقى الأثرية
تشتمل الآثار المكتشفة في هذا الموقع على أجزاء لأوانٍ من الخزف ذي البريق المعدني (لوح رقم 1) مع قواعد وفوهات لأوانٍ من الخزف المتعدد الألوان وخزف ذي لون واحد (لوح رقم 2 و 3)، بالإضافة إلى ذلك تم العثور على ثلاث جرار صغيرة من الفخار شبه كاملة مع إناء كبير من الجص (لوح رقم 4، 5، 6 و 7).
ومن المعثورات الأخرى ثلاث قنان زجاجية شبه كاملة مع فوهات وقواعد (لوح 8 و 9 و 10).
ولعل أهم ما عثر عليه قطعة من الرخام الأبيض المعرّق عليها كتابة دونت بخط كوفي هذا نصها (صنعه علي بن عيسى، ومن مميزات هذه النص دوّن بدون تنقيط (صورة رقم 52) ، إضافة إلى ذلك عثر على قطعة من الفخار صنعت من طينة ذات لون بني دونت بخط النسخ (اللين) يصعب قراءتها ( صورة رقم 53) ، ومن المكتشفات الأخرى العثور على قطع من الجص والأخشاب المتآكلة عليها آثار ألوان مائية (فرسكو) لرسوم بحالة رديئة ويغلب على الرسوم اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر والأزرق والأسمر.
ص: 350
الصورة
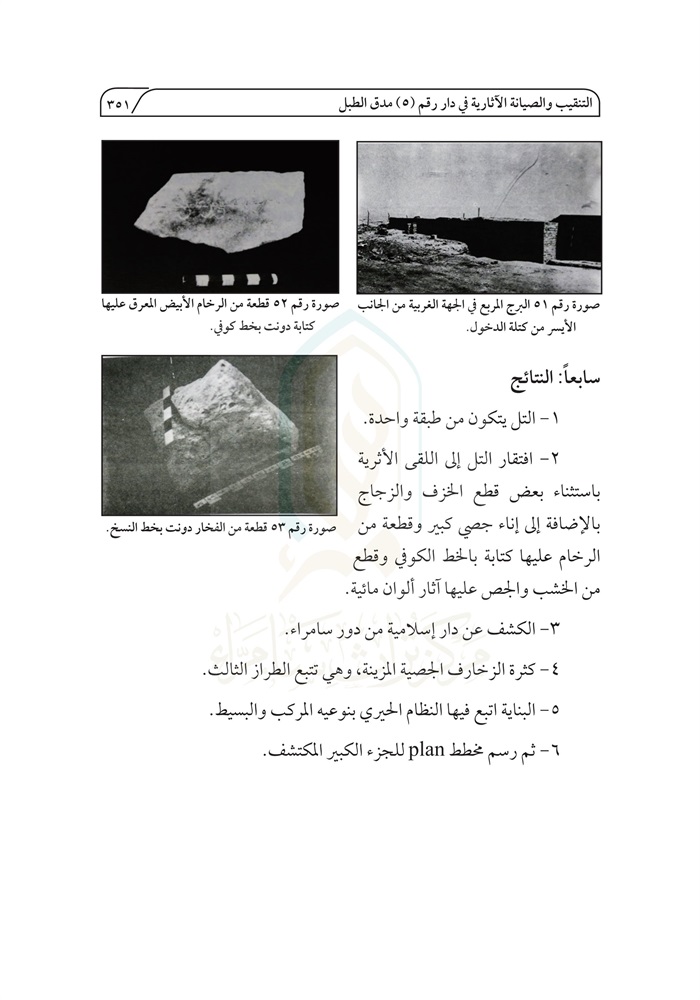
سابعاً : النتائج
1 - التل يتكون من طبقة واحدة.
2- افتقار التل إلى اللقى الأثرية باستثناء بعض قطع الخزف والزجاج بالإضافة إلى إناء جصي كبير وقطعة من الرخام عليها كتابة بالخط الكوفي وقطع من الخشب والجص عليها آثار ألوان مائية .
3- الكشف عن دار إسلامية من دور سامراء.
4 - كثرة الزخارف الجصية المزينة، وهي تتبع الطراز الثالث.
5 - البناية اتبع فيها النظام الحيري بنوعيه المركب والبسيط.
6 - ثم رسم مخطط plan للجزء الكبير المكتشف.
ص: 351
الصورة
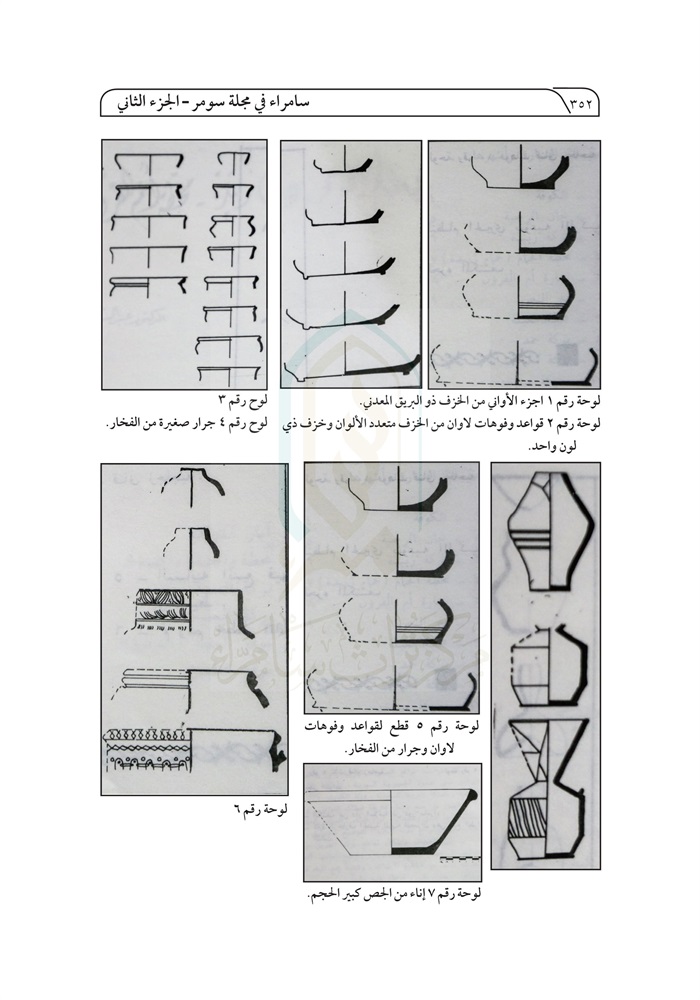
ص: 352
الصورة
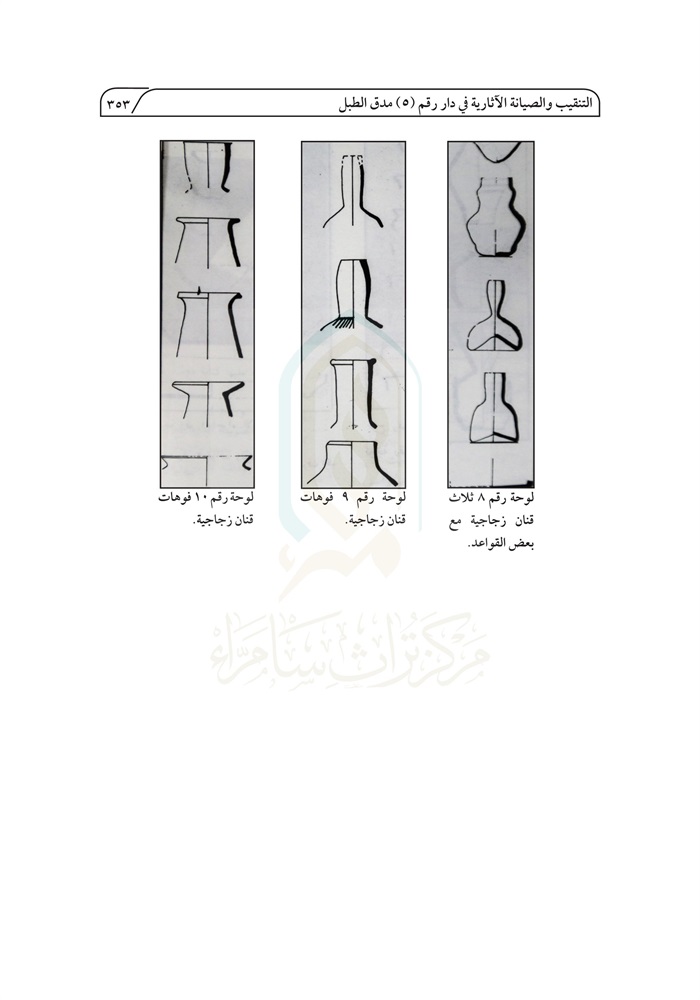
ص: 353
مصادر البحث:
1 - المسعودي، (أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي): مروج الذهب و معادن الجوهر، الجزء الرابع
2 - اليعقوبي، (احمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب): البلدان. ط 1918 م
3- د. طارق الجنابي: التنقيب والصيانة 1978 – 1981م. مجلة سومر، الجزء الأول والثاني، المجلد السابع والثلاثون، ط 1981م.
4 - د. محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر قبل الفاطميين، الطبعة الأولى، القاهرة 1974م.
5 - حفريات سامراء 1936 - 1939م. الجزء الأول، طبعة بغداد 1940 .
ص: 354
المجلد الخامس والأربعون سنة 1987-1988
خالد خليل حمودي
باحث علمي
عرف العرب قبل الإسلام الشيء الكثير عن تقسيم الزمن وعن الساعات، ومكنهم تحديد الزمن بواسطة الآلة من تسمية كل ساعة من ساعات النهار باسم خاص (1)، وفي متحف طوب قابي «سراي» في اسطنبول (تركيا) توجد مزولة شمسية من الحجر على شكل ربع كرة ذات تجويف مقسم إلى اثني عشر قسماً. وهي محمولة على قاعدة من نفس المادة وتعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، وتم العثور عليها في مدائن صالح بالجزيرة العربية (2).
وذكر حاج خليفة في كتابه متحدثاً عن علم سماه «علم البنكامات»(3): انه علم «يعني الصور والأشكال الموضوعة لمعرفة الساعات المستوية والزمانية، فإذا هو علم يعرف به كيفية اتخاذ آلات يقدر بها الزمان وموضوعه حركات مخصوصة في أجسام مخصوصة تقضي بقطع مسافات مخصوصة، وغايته معرفة أوقات الصلوات وغيرها من ملاحظة حركات الكواكب، وكذلك معرفة الأوقات المفروضة للقيام في
ص: 355
الليل إما للتهجد أو للنظر في تدابير الدول والتأمل في الكتب والصكوك والخرائط المنضبط بها أحوال المملكة والرعايا، ولا يخفى ان هذين الأمرين فرض كفاية وما لا يتم الواجب الا به فهو الواجب ... » (1).
إن تقسيمات الزمن في العصر الإسلامي كانت مماثلة لما كان موجوداً في العصور السابقة، فقد استعملت طريقتان في هذا المضمار نظراً لاختلاف آلات قياس الزمن نهاراً وليلاً. فالساعة الشمسية مثلاً هي أقدم أجهزة قياس الزمن. ولما كان النهار غير متساو في طوله في جميع أيام السنة فيجب أن يراعى ذلك الاختلاف في أي نظام لتقسيم الوقت. على أن استخدام الساعة المائية للقياس أوجد نظاماً جديداً في تقسيم النهار أو الليل إلى اثني عشر قسما منتظما . فأصبحت هناك ساعات شمسية مستوية، وساعات مائية زمانية.
والساعة الشمسية كان لها تقسيم ثابت العدد وهو (12) ساعة، حيث كان اليوم الطويل والقصير ينقسم إلى تلك الوحدات، ومن هنا نشأت الساعة الزمانية التي تكون متماثلة التقسيم في الأيام المختلفة، لكنها غير متساوية لمعظم أيام السنة قياساً إلى وحدات زمنية ثابتة؛ ذلك لأن ساعات الصيف المقسمة إلى (12) قسماً تكون أطول من ساعات الشتاء المقسمة إلى نفس الأقسام. وبالنسبة إلى الساعة المائية فإن كمية الماء المنسابة منها عبر الثقب لا تتغير (تقريبا). ولذلك تكون هناك ساعات نهار في الصيف أكثر من ساعات نهار الشتاء. وبما ان كل ساعة من تلك الساعات في جميع فصول السنة متماثلة أي بما يماثل التقسيم المعروف لدينا في الوقت الحاضر، لذلك سمي هذا النوع بالمستوية لتماثلها (2)، فالساعة المستوية - ويطلق عليها أيضاً الاعتدالية - هي التي تقيس اليوم مقسماً إلى (24) ساعة تقسيماً متساوياً كالذي نعهده اليوم، فهي لا تزيد ولا تنقص، وإنما ينقص عدد الساعات في النهار القصير، ويزداد
ص: 356
عددها في الليل وذلك في فصل الشتاء، والعكس صحيح في فصل الصيف(1).
أما بالنسبة إلى الساعة الزمنية فهي التي يكون فيها اليوم مقسماً إلى قسمين كل قسم اثنتا عشرة ساعة مهما طال النهار أو قصر ، ولذلك فهي تكون طويلة في النهار الطويل وفي الليل الطويل، وقصيرة في النهار القصير والليل القصير، ولا تتماثل الساعات فيها الا وقت الاعتدالين، وهكذا تكون متغيرة بتغير فصول السنة (2).
عرف العرب المسلمون أنواعاً شتى من الساعات المائية لكن أشهرها ساعة المدرسة المستنصرية التي أسهبت المراجع في وصفها والإعجاب بها وكيفية عملها ليلاً ونهاراً. ففي سنة 633 هجرية (1235 ميلادية) تكامل بناء الإيوان الذي أنشئ مقابل باب المدرسة المستنصرية، وكان في صدره صندوق الساعات على وضع عجيب يعرف منه أوقات الصلاة وانقضاء الساعات الزمانية نهاراً وليلاً، والصندوق قوامه دائرة فيها صورة الفلك وتظهر عليها طاقات لها أبواب لطيفة، وفي الدائرة بازان من ذهب في طاستين من ذهب وراءهما بندقتان من نحاس لا يراهما الناظر، وعند مضي
الصورة

ص: 357
كل ساعة ينفتح فما البازين وتقع منهما البندقتان، وكلما سقطت بندقة انفتح باب من أبواب الطاقات، وحينئذ تمضي ساعة زمنية، والبندقتان الواقعتان في الطاستين تذهبان إلى مواضعهما، ثم تطلع شموس من ذهب في سماء لازوردية في ذلك الفلك من طلوع الشمس الحقيقية وتدور مع دورانها وتغيب مع غيابها، فإذا جاء الليل فهناك أقمار طالعة من ضوء خلفها كلما تكاملت ساعة تكامل ذلك الضوء في دائرة القمر، ثم يبتدئ في هذه الدائرة الأخرى إلى انقضاء الليل وطلوع الشمس فيعلم بذلك أوقات الصلاة (1)، وهكذا توضح لنا هذه الساعة مدى ما وصل إليه التقدم العلمي والفني في العصر العباسي(2).
الصورة
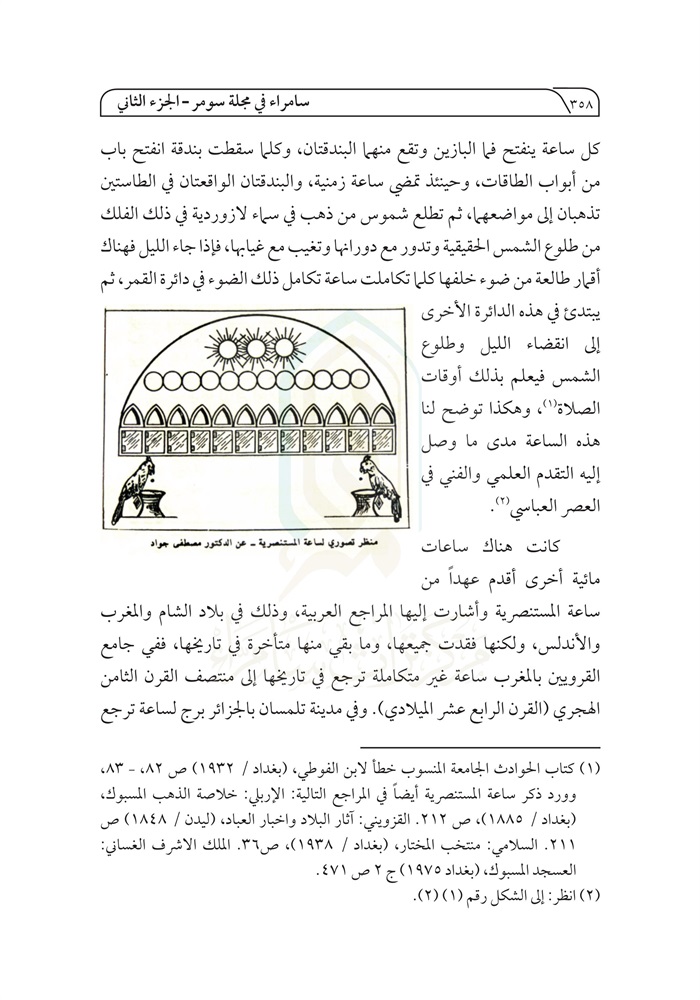
منظر تصوري لساعة المستنصرية - عن الدكتور مصطفى جواد
كانت هناك ساعات مائية أخرى أقدم عهداً من ساعة المستنصرية وأشارت إليها المراجع العربية، وذلك في بلاد الشام والمغرب والأندلس، ولكنها فقدت جميعها، وما بقي منها متأخرة في تاريخها، ففي جامع القرويين بالمغرب ساعة غير متكاملة ترجع في تاريخها إلى منتصف القرن الثامن الهجري (القرن الرابع عشر الميلادي). وفي مدينة تلمسان بالجزائر برج لساعة ترجع
ص: 358
إلى نفس التاريخ تقريبا(1)، على أنه تبين مؤخراً أن أقدم ساعة مائية موجودة في العالم هي تلك التي بمدينة فاس بالمغرب، وكتب عليها تاريخ صنعها في سنة 763 هجرية (1362 ميلادية) (2). وهكذا كانت الساعات العربية ذائعة الصيت عجيبة الصنع تفاخر في أهدائها الخلفاء والحكام والأثرياء، وليس أدل على ذلك من الساعة التي أهداها الخليفة هارون الرشيد إلى شارلمان أو تلك الساعة التي أهداها القائد صلاح الدين الأيوبي إلى فردريك الثاني سنة 630 هجرية (1232 ميلادية ) (3).
الساعات الشمسية
للعرب فضل كبير في ميدان الساعات الشمسية تذكر المستشرقة زيغريد هونکه (Hunke) حول هذا الموضوع فتقول: امتاز العرب بمهارة فائقة في اختراع ساعات الشمس وأعطوها شكلاً دائرياً يتوسط محوراً دائرياً، وتمكنوا بواسطتها من تحديد موضع الشمس في كل حين ومن تحديد الوقت ووضع التقاويم الزمنية. وكانت ساعة الشمس النقالة الأسطوانية أكثر اختراعاتهم أصالة وفناً في هذا الحقل وقد وصلت هذه الساعة أو ساعة الرحلة كما يسمونها ، إلى أيدي هرمان الكسيح في دير (رايخنو)، فقام بوصف هذه الآلة العجائبية وصفاً حسياً عملياً، وانتشرت هذه الساعة في أكثر أطراف بلاد الغرب بعد ذلك الزمن بقليل»(4)، كما أوجدوا الساعة
ص: 359
الشمسية الدقاقة التي تعلن ساعة الغداء بصوت رنان(1).
ومن أهم أنواع الساعات الشمسية العربية تلك التي كانت تسمى (الرخامة). وقد ذكر ابن أبي أصيبعة، وهو من علماء القرن السابع الهجري (القرن الثالث عشر الميلادي).
إنّ ثابت بن قرة المتوفى سنة 288 هجرية ( 900 ميلادية)، وهو من العلماء النابغين في الرياضيات والفلك والفلسفة والطب ألف كتاباً عنوانه (كتاب في الات الساعات التي تسمى رخامات) (2) ، وكذلك قام الخوارزمي المتوفى سنة 236 هجرية (850 ميلادية)، وهو من مشاهير علماء الرياضيات والفلك، بتأليف كتاب سماه (الرخامة) (3)، وذكر ابن النديم عدداً من العلماء الذين كتبوا عن هذا النوع من الساعات، منهم حبش بن عبد الله المروزي الحاسب الذي ألف (كتاب الرخائم)، ومحمد بن كثير الفرغاني الذي ألف كتاباً في (عمل الرخامات)، ومحمد بن بني الصباح، وكانت له (رسالة في صنعة الرخامات)، وابو عبد الله الشلوي، وله (كتاب عمل الرخامة المنحرفة)، وكتاب آخر اسمه (الرخامة المطيلة ) (4).
الساعة الشمسية المكتشفة في سامراء
في سنة 1972 كان عمال الهاتف بمدينة سامراء يقومون بأعمال الحفر لمد الأسلاك، وفجأة ظهرت لهم لوحة شبه مربعة من الرخام العراقي تهشمت عند استخراجها حيث جلبت إلى المتحف العراقي ببغداد فتمت معالجتها مختبريا وترميمها، فكانت المفاجأة حينما ظهرت معالمها وما تحمله من خطوط وكتابات
ص: 360
عربية، وأنها تمثل ساعة شمسية، فتم تسجيل هذه القطعة الأثرية النادرة في السجل العربي العام تحت رقم (11275 - ع). ثم نقلت هذه الساعة في حينه إلى متحف البصرة لتستقر هناك حتى سنة 1984 ، حيث جرى نقلها إلى بغداد وعرضت في القاعة الإسلامية الأولى في البناية الجديدة للمتحف العراقي الذي تم توسيعه مؤخراً .
الوصف:
اللوحة مربعة الشكل تقريباً، طولها 80 سنتمترا وعرضها 76 سنتمترا، وفي أعلى اللوحة سطر من كتابة عربية محفورة على اللوحة بشكل حزّ عميق قوامها عبارتان تلك التي على الجهة اليمنى نصها: ساعات زمانية لغرض أد» (؟) وعلى الجهة اليسرى عبارة: صنعة علي بن عيسى، وبأسفل ذلك خطوط يلاحظ فيها خطان رئيسان متقاطعان ومتعامدان يوضح أحدهما اتجاه الشمال، حيث كتب في أعلاه كلمة (الشمال)، وكتب في أسفله كلمة (الجنوب)، كما وتوجد على هذا الخط عبارة نصّها (خط نصف النهار) ، مما يدل على كونه ينصف الساعة إلى نصفين متساويين . أما الخط الثاني الذي يتقاطع معه فيوضح الجهتين الأخريين حيث كتب على اليمين كلمة (المشرق) ، وعلى اليسار كلمة (المغرب) ، وهكذا يوضح لنا الخطان المذكوران الجهات الأربع، حيث يجب ضبط اللوحة (الساعة) حسب تلك الاتجاهات اذا ما أريد العمل بها. وتوجد خطوط تمتد من الشرق إلى الغرب تتقاطع مع خط الشمال بشكل زوايا منفرجة، مكونة ستة حقول أفقية غير منتظمة في عرضها؛ إذ إنها تتسع كلما ابتعدت عن خط الشمال نحو الشرق والغرب. وعن يمين ويسار خط الشمال وتوجد خطوط عمودية موازية له تقريباً تقسم اللوحة إلى (24) قسماً كل (12) قسماً على جانب من جانبي خط الشمال، حيث كتبت عليها الساعات ابتداء من جهة اليسار (جهة المغرب على الساعة أو اللوحة)، وبقيت منها كلمات تشير إلى (ساعتان) و (ثلاث) و(أربع)، وفقدت المعالم التي تشير إلى الساعات الأخر، في حين لا نجد معالم للكلمات التي تشير إلى الساعات على الجانب الأيمن من الساعة (اللوحة) ، وهناك كتابات تشير إلى
ص: 361
موعد وقت العصر، حيث وردت عبارة في الجانب الأيمن نصها (ساعة وقت صلاة العصر)، ومن المعلوم ان استخراج الوقت يتم بواسطة الظل الذي يتركه الوتد المثبت أسفل خط الشمال السالف الذكر، حيث لا يزال الثقب الصغير الذي يثبت فيه الوتد موجوداً على اللوحة. ويلاحظ أيضاً خط آخر يخرج من نفس موضع تثبيت الوتد باتجاه الجنوب الغربي يوضح بلا شك خط اتجاه القبلة (مكة المكرمة) بالنسبة للعراق. شكل (3).
إنّ استخراج الوقت ومعرفته في العصر الإسلامي أصبح من الأمور التي يجب على كل مسلم أن يكون على بينة منها لمعرفة مواقيت الصلوات الخمس المفروض عليه في كل يوم، والتي لكل منها وقت محدد لا ينبغي تجاهله؛ إذ هو من شروط صحة الصلاة نفسها (1) ، ولذلك اجتهد العلماء منذ فجر الإسلام بتحديد وقت كل صلاة معتمدين في ذلك على تعاليم الإسلام، ومستخدمين طريقة سهلة يمكن بواسطتها لكل شخص الاهتداء إلى الوقت، وذلك بالاعتماد على ظل الشمس.
الصورة
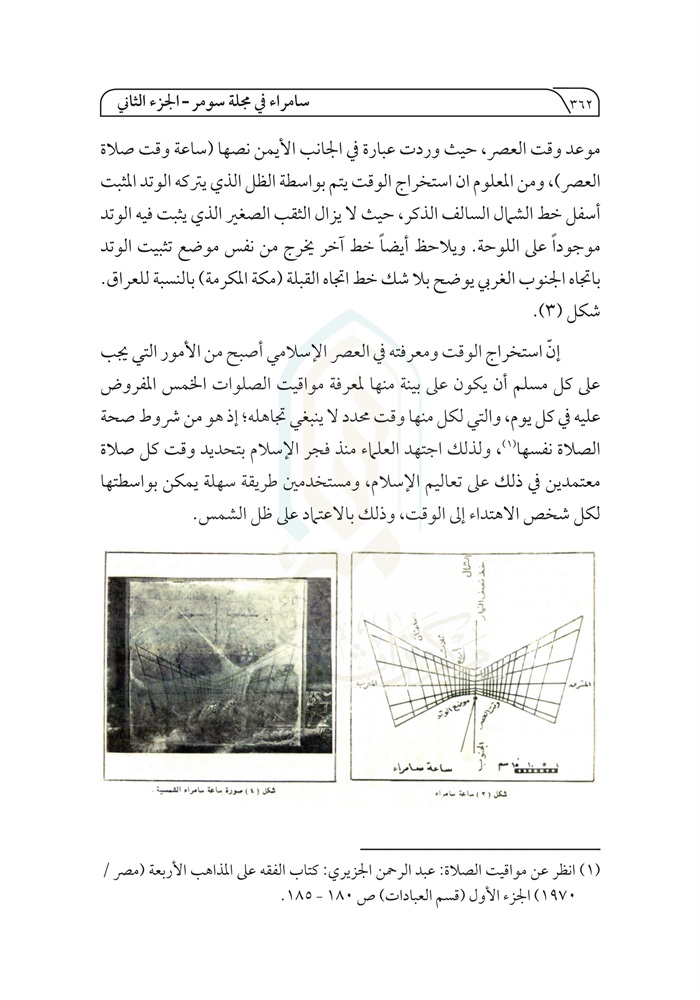
ص: 362
واستنادا إلى ذلك فان ما ورد في ساعة سامراء من تقسيمات يختصر باثنتي عشرة ساعة من ساعات النهار، ففي أقصى جهة اليسار تبدأ الساعة الواحدة صباحاً وتنتهي في وسط النهار الذي هو وقت الظهر في الساعة السادسة، ثم تبدا الشمس بالزوال ويزداد الظل تدريجياً حتى يأتي وقت العصر، وعندما تغيب الشمس ينتهي النهار، وتكون الساعة حينئذ هي الثانية عشرة حيث يحل وقت المغرب. وما يزال هذا الأسلوب متبعاً حتى الوقت الحاضر في تحديد اوقات الصلوات اليومية.
صانع ساعة سامراء
وردت عبارة صنعه علي بن عيسى على ساعة سامراء، ولدى البحث عن ترجمة هذا الصانع في المراجع العربية وجدنا هذا الاسم يرد بكثرة، ولكننا لم نستطع ان نهتدي إلى أي واحد منهم قام بصناعة ساعة سامراء، فقد ذكر ابن النديم ان (علي بن عيسى غلام المروروذي) (1)، ويقصد بذلك ان هذا الصانع أخذ العلم عن أحد علماء الفلك المشهورين في عصره، وهو عمر بن محمد المروروذي مؤلف كتاب صنعة الاسطرلاب المسطح ، ثم ذكر أيضاً انه كان لعلي بن عيسى هذا غلامان أخذا عنه وهما أحمد و محمد ابنا خلف (2)، ومما قيل أيضاً إنّ علي بن عيسى كان طبيباً للخليفة العباسي المعتمد على الله (256 - 279 هجرية / 870-192 ميلادية) (3)، ووردت أيضاً إشارة إلى اسم علي بن عيسى الاسطرلابي، عاش في عهد خلافة المأمون وذكره سند بن
ص: 363
علي المنجم (1) في رواية ذكرتها بعض المراجع العربية، وهي ان الخليفة المأمون أمره هو وخالد بن عبد الملك المروالروذي (2) أن يقيسا مقدار درجة أعظم دائرة من دوائر سطح الأرض (أي محيط الكرة الأرضية) فسارا إلى جهة تدمر.
وأمر علي بن عيسى الاسطرلابي وعلي بن البحتري بمثل ذلك فسارا إلى ناحية أخرى هي ناحية سنجار ، وقد ورد الكتابان من الناحيتين المذكورتين في وقت واحد بقياسين متفقين (3).
واورد ابن خلكان ما يشبه هذه الرواية أيضاً(4)، وتجدر الإشارة هنا إلى وجود مخطوط اسمه (كتاب العمل بالاسطرلاب) (5)، ومؤلفه علي بن عيسى، وتوجد نسخة في مكتبة المتحف العراقي من رسالة في الاسطرلاب لعلي بن عيسى الاسطرلابي(6)، ومما جاء في كتاب العمل بالاسطرلاب صنعه علي بن عيسى المنجم: أول ما يحتاج إليه من
ص: 364
عمل الاسطرلاب معرفة ... ثم معرفة الساعات المستوية، ثم معرفة استخراج ما مضى من الليل من ساعة...ثم معرفة أجزاء ساعات النهار وساعات الليل وكم كل واحد منهما من الساعات المستوية، ثم معرفة الساعات المستوية بالليل (1) .
ورغم اننا لا يمكننا البت في أي واحد من اولئك المذكورين قام بصنع ساعة سامراء، الا اننا نرى بأن مذكرة ابن النديم من كون علي بن عيسى هو تلميذ عمر بن محمد المر والروذي الذي عاش جده خالد بن عبد الملك المروروذي في بلاط المأمون، مما ينبغي أن يكون علي بن عيسى المذكور في كتابه قد عاش بعد خلافة المأمون، ولما كان الخليفة المعتصم بالله قد نقل مركز الخلافة العباسية إلى مدينة سامراء التي بناها وانتقل إليها في سنة 221 هجرية (835 ميلادية) فمن المرجح أن يكون علي بن عيسى قد عاش في سامراء.
وهكذا يمكننا أن نستخلص مما سبق بأن ساعة سامراء الشمسية قد صنعت على الأقل في أواسط القرن الثالث الهجري (القرن التاسع الميلادي)، وعلى هذا فهي أقدم ساعة من نوعها تعود إلى العصر الإسلامي، واكتشفت في عاصمة العباسيين سامراء، وعليها اسم صانعها، ولذلك تعد مفخرة من مفاخر الحضارة العربية الإسلامية.
ص: 365
الصورة
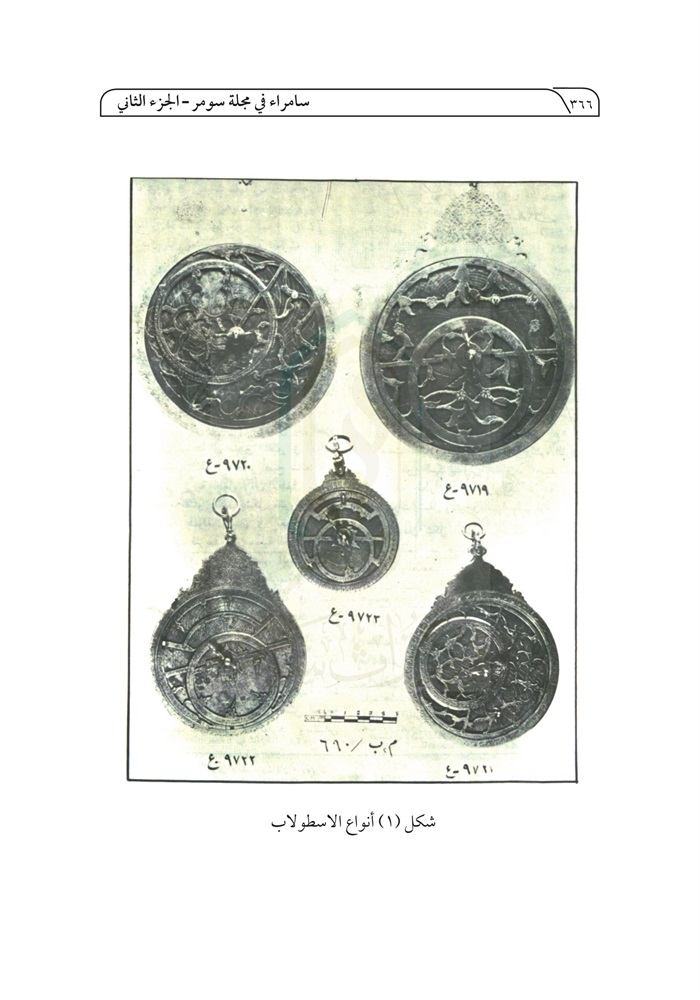
ص: 366
المجلد السابع والأربعون سنة 1995م
«مسجد سور عیسی»
صباح محمود القاضي
باحث علمي
يعد تصميم المسجد فكرة عربية إسلامية أنشئت بوحي من الإسلام، ولم ينظر قبل إنشائه إلى عمارة المعابد السابقة للإسلام كمعابد اليهود وكنائس النصارى(1)، فقد أوحت الظروف الدينية للعرب المسلمين فكرة تأسيسه وأصوله التخطيطية، ويعد مسجد الرسول صلّی الله علیه و آله النواة الأولى لمعظم مساجد العالم الإسلامي التي جاء تخطيطها على غرار مسجد الرسول صلّی الله علیه و آله فكان المسجد يتكون من بيت للصلاة يحتوي على أروقة موازية لجدار القبلة (أساكيب) يحدد عددها بعدد الدعامات أو الأعمدة القائمة في بيت الصلاة ومن المساجد ما أقيمت سقوفها فوق الأعمدة القائمة أو الأكتاف مباشرة، ومنها أن تكون سقوفها على العقود القائمة فوق الأعمدة، ويحتوي المسجد على فناء مكشوف (الصحن ) يطل عليه بيت الصلاة، وللمسجد جدران سميكة تحدد مساحة المسجد مربعة أو مستطيلة وللمسجد مجنبتان وقد يستغنى أحياناً عن المؤخر أو المجنبتين، أو يكتفى ببيت الصلاة(2) يقوم أمامه رواق يستخدم عادة للصلاة في حالة ضيق المصلي بالمصلين. وكان من حرص المسلمين على أداء فريضة الصلاة في أوقاتها المحددة إذ أنشأوا
ص: 367
مساجد خاصة بأفراد أو قبائل أو مساجد محلية علاوة على المساجد الجامعة، وهذا الاتجاه في إنشاء مساجد خاصة أو محلية أصبح متبعاً في العصور التالية لعصر الخلفاء الراشدين؛ لاتساع رقعة الدولة الإسلامية وتمصير الأمصار، فقد أنشئت المساجد على هذا المنوال (1).
ويروى ان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) كتب إلى أبي موسى الأشعري في البصرة وسعد بن أبي وقاص في الكوفة وعمرو بن العاص في مصر أن يبنوا مسجداً جامعاً ومساجد للقبائل وعلى الناس ان يصلوا في المسجد الجامع(2)، وفي العصر العباسي أقيم العديد من المساجد فيها المسجد الجامع في مدينة المنصور المدورة الذي أعيد بناؤه في عهد الخليفة هارون الرشيد وزينت جدرانه، كما بني جامع الخلفاء وجامع الحربية.
ومدينة سر من رأى التي أنشاها الخليفة العباسي المعتصم بالله بن هارون الرشيد عام (221 ه_ / 836 م ) لتكون عاصمة للخلافة العباسية بدلا من بغداد فاستقدم لبنائها العمال والبنائين والمهندسين وأهل المهن كافة من كافة أنحاء الدولة العربية المترامية الأطراف (3).
فقدر السامراء أن تكون البوتقة التي انصهر فيها الفن العراقي الاصيل مع الفنون العربية الاخرى وولادة فن جديد هو الفن العربي الإسلامي، الذي استقت من منهله بقية المدن الإسلامية الأخرى، فشيدت فيها المساجد والقصور الواسعة وبنى الناس ما بين هذه القصور فكانت قصور الخلفاء والأمراء و خاصة الناس واسعة تضم داخل أسوارها أماكن خاصة لأصحابها وأماكن أخرى للقائمين على خدمته وأماكن خدمية أخرى، وأفنية واسعة تضم مساحات مزروعة ونافورات
ص: 368
بديعة وأماكن خاصة لاستقبال الضيوف ومساجد ومصليات لأداء فريضة الصلاة في أوقاتها المحددة، وظاهرة إقامة مساجد خاصة أو مصليات كانت قائمة منذ العصر الأموي، إذ تشترك معظم القصور الأموية باحتوائها على مصلى، ويعد مصلى قصر الحلابات (104ه_ / 105 ه_) من أقدم هذه المصليات، أما في العراق فإن أقدم مسجد أو مصلى تم الكشف عنه هو مصلى قصر الأخيضر (منتصف القرن الثاني للهجرة) (1).
لقد روعي في تخطيط مدينة سامراء امتدادها طوليا وجاء هذا الامتداد منسجما مع امتداد نهر دجلة، إذ تمتد خرائبها مسافة (34 كم) منها (8 كم) جنوب بلدة سامراء الحالية و (26 كم) شمالها، ويراوح عرضها ما بين (2) - (4) (كم) (2) (الشكل 1) أن هذا الامتداد الكبير جعل من العسير أداء فريضة الصلاة في جامعها الكبير سواء أكان جامع المتوكل في سامراء (جامع الجمعة) أم جامع (أبو دلف) في المتوكلية، نظراً للوقت الطويل الذي يتطلبه الوصول إلى المسجد الجامع، لذلك عني سكان مدينة سر من رأى بإنشاء مساجد صغيرة ومصليات داخل حدود إقطاعاتهم أو داخل قصورهم ودورهم الكبيرة أمكن الاستدلال عن عدد منها خلال التنقيبات التي أجرتها البعثات الأجنبية أو هيئات التنقيب العراقية ، أو من خلال الصور الجوية المأخوذة للمدينة الأثرية حيث يمكن
الصورة
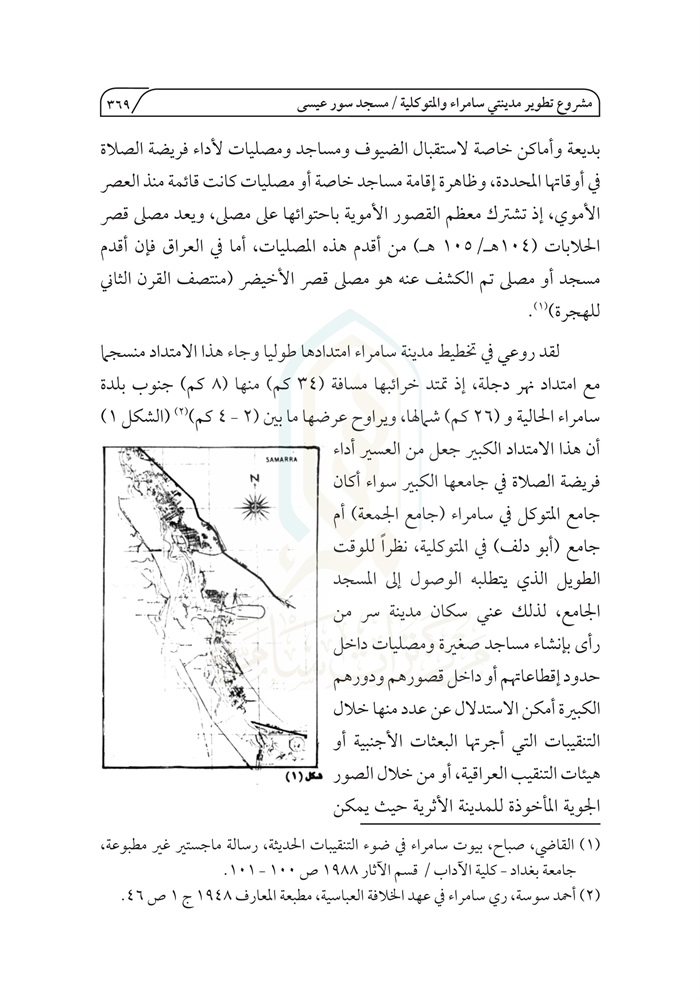
ص: 369
الاستدلال عليها بسهولة من خلال انحراف جدار القبلة عن بقية جدران دور المدينة وقصورها.
وضمن الحملة الأولى لمشروع إنقاذ آثار مدينتي سامراء والمتوكلية تم العمل في الموقع المعروف بسور عیسی(1)، ويشغل هذا الموقع مساحة (421م) طولاً و(211م) عرضاً ولا نعرف أن كان هناك علاقة لعيسى هذا بتسمية الموقع ، وربما كان هذا الموقع يضم أحد قصور الأمراء أو الأميرات وربما هو قصر أم عيسى ابنة الخليفة الواثق (2) فتم الكشف عن وحدة سكنية ومسجد صغير في الجهة الشمالية الغربية داخل السور وصيانة الواجهة الشرقية للسور (الشكل 2).
يشغل المسجد شكلاً مستطيلاً غير منتظم الأضلاع يبلغ طول جدار القبلة فيه (14,80م) ، ويبلغ طول جداره الشرقي (31م) يتكون بيت الصلاة فيه من اسكوبين وثلاثة بلاطات، أي انه يمتد ببيت الصلاة صفان من الأكتاف (الدعامات) موازية لجدار القبلة بكل صف منها دعامتان
الصورة
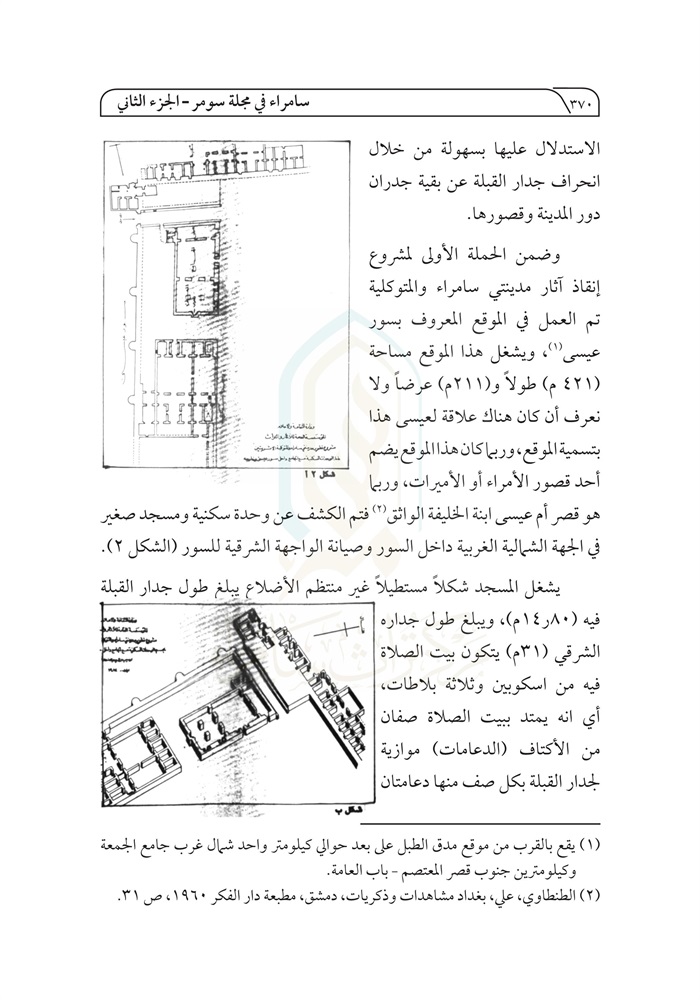
ص: 370
(الشكل 3) ولبيت الصلاة محراب ذو تجويف مستطيل تبلغ سعة فتحته (1/07 م) وعمقه (1/15م) ، وما تبقى من ارتفاعه (1م)، يحف بكل من جانبيه عمودان جصيان وفي صدر تجويفه عقد زخر في ذو ثلاثة فصوص (الشكلان 4 أ و 4 ب)، وتجويف محراب المسجد على غرار محراب المسجد الجامع في سامراء(1)، أما صحن المسجد فمربع الشكل تقريباً طول ضلعه (14,80م)، وللمسجد مؤخرة يبلغ عرضها (14,80م) وعمقها ( 4/30 م) ، تفتح على الصحن بمدخلين جانبيين، ويتوسط ضلعها المواجه للقبلة محراب مجوف يستدل من بقاياه انه مشابه لمحراب بيت الصلاة الا انه أصغر منه حجماً، تبلغ سعة فتحته
الصورة

(1 م) وعمقه (55 سم)، ويحف بكل شكل ا ب من جانبيه عمودان حصيان (الشكلان 5 أ و 5 ب)، ومن المرجح ان الصلاة تجرى في المؤخرة شتاء، لكونها لا تتصل بالصحن الا من خلال المدخلين اللذين أشرنا اليهما أو إنها كانت خاصة كمصلى للنساء. وللمسجد ثلاثة مداخل اثنان منها في ضلعه الشرقي يؤدي أحدها إلى صحن المسجد، والثاني إلى مؤخرته، أما المدخل الثالث فيؤدي إلى مؤخرته من ضلعه الغربي
ص: 371
حيث المطامير، ومما يجدر ذكره ان المعمار قد استغل سمك جدار المسجد الشرقي البالغ (2 م ) فعمل فجوات جدارية، اثنتان منها على جانبي المدخل واثنتان في بيت الصلاة، من المرجح انها كانت لحفظ الأثاث الخاص بالمسجد أو اتخاذ البعض منها وخاصة في بيت الصلاة، كمكتبة لحفظ المصاحف والكتب الدينية.
إن ظاهرة إقامة محراب في مؤخرة المسجد في الرواق ظاهرة معروفة في إقامة معظم المساجد التي أقيمت خلال العصر العباسي؛ وذلك لاستخدامها في إقامة الصلاة في حالة ضيق المصلى بالمصلين.
الصورة
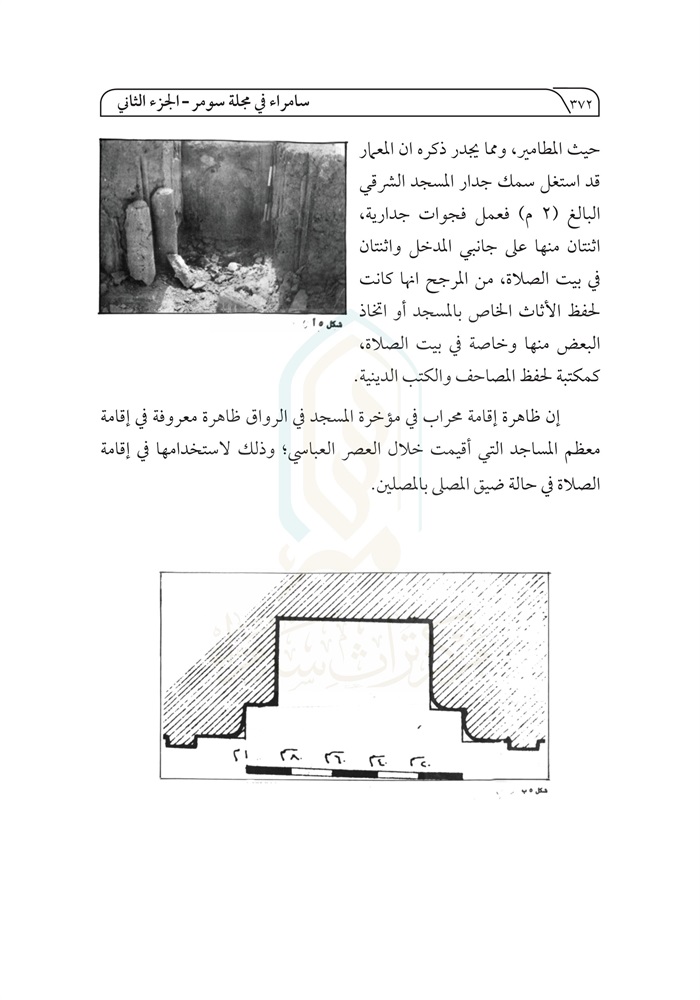
ص: 372
المجلد الثامن والأربعون سنة 1996م.
تنقيب وصيانة
حافظ حسين الحياني - منقب آثار
حسين عبيد على منقب آثار
لا يخفى ما لسر من رأى «سامراء» العباسية من أهمية خاصة من الناحية الأثرية بين مدن العراق عبر العصور. ذلك أنها شيدت وازدهرت وهجرت خلال فترة وجيزة (حوالي نصف قرن)، لذلك فإن كل ما فيها من المباني واللقى الأثرية تؤرخ بصورة دقيقة للقرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي.
وإذا كان لم يصلنا من آثار مدينة المنصور (بغداد) ما يمكن الاستدلال به على ما أوردة الخطيب البغدادي، فإن مدينة سامراء التي تعرضت لتجاهل من قبل المؤرخين والجغرافيين القدامى من قاومت عاديات الزمن واحتفظت بمعظم عناصرها العمارية والزخرفية عبر أحد عشر قرناً في حالة جيدة، يمكن الاستدلال منها على نظام تخطيطها فضلاً عن كونها قد أمدتنا بوثائق علمية، كشفت عن عظمة الحضارة العربية الإسلامية من العصر العباسي.
ولأهمية هذه المدينة، فقد أولت دائرة الآثار والتراث اهتمامها بإجراء عمليات تنقيب وصيانة معظم المباني والتلول الأثرية فيها، وكان من بين هذه التلول (منخفض تحيط به التلول) يقع داخل دار الخلافة، حيث شكلت هيئة برئاسة السيد حافظ حسين الحياني، وعضوية كل من السيد حسين عبيد علي، والسيد قاسم راضي، والسيد عبد الرحمن محمد علي، والسيد محمد إبراهيم القزاز والسيد أحمد رشوان، للعمل على إجراء تنقيب وصيانة هذا الموقع، وكشفت لنا هذه الهيئة بناءً أطلق على تسميته البركة.
ص: 373
(مخطط رقم - 1-).
تقع البركة إلى الشرق من مدخل قصر الخليفة المعتصم (باب العامة) بسامراء (مخطط -1-) ، وكانت تعرف قبل ذلك عند المشتغلين بالآثار بأسماء عديدة(1)، من قبل العلماء الأجانب والرواد الأوائل لعلم الآثار في بلاد ما بين النهرين(2) ومن الجدير بالذكر، إن جميع الأسماء والمخططات تخالف الواقع الذي تم العثور عليه ما عدا ما ذکره د./ أحمد سوسة في كتابه ري سامراء، فهو قريب من الحقيقة حيث يقول: إن المتوكل لم يكتف ببناء هاوية السباع (الحير ) باعتبارها مجلساً صيفياً نهارياً، بل أراد أن يبني مجلساً صيفياً ليلياً فكان له ما أراد وبنى هذه البركة، وهي أكبر وأعمق من الحير، وذلك في الجهة الشمالية (3).
تاريخ البركة
نظراً لعدم وجود وثيقة تدل على تاريخ البركة سوى ما ذكر [من] أنها تقع في قصر الخليفة المعتصم والذي سكن به الخلفاء من بعده باستثناء بعض الفترات الزمنية القصيرة، لذلك يجب علينا أن نتبع الأسلوب العلمي الدقيق لتاريخ البركة، وفيما يلي المعلومات التي ترجح أنها من أعمال المتوكل الذي تولى الحكم سنة 232ه_ وإلى 249ه_ .
يعتبر المعتصم مؤسس مدينة سامراء، والمتوكل مطوراً لها، حيث أشار اليعقوبي في كتاب البلدان إلى ترك آثار عمارية ضخمة وعظيمة؛ لذلك يعتبر المتوكل في طليعة الحكام العظماء في عمارة سامراء. وقد أورد ابن حمدون والغزولي وياقوت الحموي،
ص: 374
ما يشير إلى ذلك، فذكر الغزولي، انه نقل معلوماته عن أبي الفرج الأصفهاني، حيث قال: حدثني بذلك جماعة منهم أبو عثمان يحيى بن عمر قال بعض الدواوين ان... المتوكل أنفق على أبنيته وقصوره والمسجد الجامع ومتنزهاته في خلواته بسامراء الكثير من الأموال، مشيراً إلى الأرقام الضخمة من الأموال، ومنها الماحوزة خمسون مليون درهم، وعلى قصر العروس ثلاثون مليون درهم وعلى البهو خمسة وعشرون مليون درهم، وعلى بلكوارا عشرون مليون درهم كما أن المتوكل مشهور بالبذخ وعمارة العديد من المباني.
ويذكر ياقوت انها كلفت 294 مليون درهم. ويذكر في مطالع البدور ديناراً(1) وليس درهماً، هذا يدل على أن العمارة في عهد المتوكل ازدهرت الحياة الاقتصادية. ويذكر المسعودي: «أحدث المتوكل بناءاً لم يكن يعرفه الناس من قبل»(2). ويذكر أيضاً أن الخليفة المتوكل كان شغوفاً بحب الأعمال الإعمارية العظيمة. ويذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان رسماً يبين أحد من الخلفاء في سر من رأى من الأبنية الجليلة مثل ما بناه المتوكل).
أما الطبري فيشير إلى مدى حب وعلم المتوكل بالعمارة فيقول: «إذا علمنا ان المتوكل كان مولعاً بنقض المباني حتى تلك التي اشادها بنفسه واستخدم موادها في مبانٍ أخرى فأمر بنقض القصر المختار بيع ونقل ساحبها إلى الجعفري».
ويذكر الدكتور / احمد سوسة/ في كتاب ري سامراء: (الظاهر ان المتوكل لم يكتف بهذا المخبأ (الحير) الذي اقتصر استعماله على أوقات النهار، بل عزم على إنشاء بركة أخرى على شكل بركة ليلية مكشوفة يقضي فيها بعض جلساته...). وكان له ما
ص: 375
أراد(1)، مشيراً إلى البركة التي نحن بصدد الحديث عنها، ومما سبق ذكره يتوضح لنا مدى حب المتوكل وكثرة أعماله العمارية والمشروعات المائية التي أنشئت في عهده، والتي تغذي وتصرف مياه البركة، ما يؤكد لنا ان البركة من أعمال المتوكل وأن كثرة القصور وعظمة البناء وجمالها ترتبط بالتقدم الحضاري والفني والوضع المالي، ولقد أثبتت كل الروايات التاريخية ان المتوكل توفرت له هذه الإمكانيات وكذلك الطراز الحيري المتطور في عمارة البركة يؤكد انها من أعمال المتوكل.
الغرض من إنشاء البركة.
أنشئت من أجل استمتاع وخلق جو رطب لراحة الخليفة في أوقات الصيف، من المعروف أن جو العراق حار صيفاً، ولقد اهتم بذلك الإنسان العراقي منذ القدم بالتحايل والتأقلم مع الجو والاهتمام بوسائل التبريد والتهوية، وتطور بعد ذلك فأنشأ البرك.
يذكر اليعقوبي: (وسير في كل بستان قصراً فيه مجالس وبرك وميادين فحسنت العمارة ...) . ومن هذه العبارة ومن خلال التنقيبات نستدل على مدى الاهتمام بالبرك لتلطيف الجو ولتحسين وتزيين العمارة من هذا المبدأ ازداد الاهتمام بإنشاء البرك للتلطيف والإبداع في عمارتها، فظهرت لنا هذه البركة في قمة الإبداع الهندسي العماري والفن الزخرفي، أي انها حوت إبداع الفنون الإسلامية، بالإضافة إلى ارتفاع جدرانها من أجل الحفاظ على درجة الرطوبة في أوقات الحرارة الشديدة، ومن واقع العمل بهذه البركة تبين لنا انها قصر تزينه بركة وليس بركة فقط.
استعملت أنابيب فخارية في أسفل حافة حوض المياه الدائري من الداخل بألواح من المرمر للزينة، كما ان تساوي المسافات بين القاعات وحوض المياه الدائري يعمل على جعل درجة التلطيف متساوية في مختلف القاعات حتى يتمكن من الجلوس
ص: 376
في أي قاعة في مختلف الأوقات.
كانت البركة قبل التنقيب عبارة عن تلول من الأنقاض متفاوتة الارتفاعات تتراوح ما بين (3-5)م ، تحيط بحفرة صغيرة عميقة مليئة بالأعشاب الطبية نتجت عن تجميع مياه الأمطار بها.
لقد قام المنقبون بحفر مجس في عام 1987 ، فكشفوا عن الكهريز الفرعي وبداية الممر الدائري (لوحة رقم 1) ، وهذا ما شجعنا على إجراء تنقيبات واسعة بالبركة، فبدأت التنقيبات في شهر شباط / 1988 ، واستمرت حتى شهر كانون الأول/ 1989( لوحة رقم 2).
لقد ظهر لنا الجدار الشمالي وبداية أعلى المداخل (لوحة رقم 3)، وهذا ما جعلنا نعيد النظر في طريقة التنقيب (1) ، ونتتبع الجدران، ومن ثم الوصول إلى أرضية الأبنية التي ظهرت على عمق (13م) من مستوى الأرض الأصلية التي هي بمثابة الدليل القوي للمنقب للاهتداء إلى الأبنية، حيث كانت مبلطة بطابوق فرشي قياس (50×50×5سم) .
استمر العمل في تلك الواجهة، حيث تم استظهار الأبنية التي كانت ارتفاعات الأجزاء المتبقية منها يتراوح بين (1 - 7 م) ، مبنية بالآجر والجص الذي استخدم كمادة رابطة، واستخدم أيضاً في تغليف الأبنية وفي زخرفة الجدران، ومن ثم توصلنا إلى استظهار الواجهة الغربية والجنوبية والشرقية وحوض المياه الذي يتوسط تلك الواجهات . الألواح (4) ، (5) ، (6)، (7) التي تمثل مراحل العمل، بعد الكشف التام والدقيق عن تلك الأبنية تبين لنا أنها قصر تتوسطه بركة قطرها (62م) بعمق (2م) تتخللها 4 مداخل رئيسة وثمانية فرعية تؤدي إلى القاعات والأواوين.
ص: 377
التخطيط
تحتل البركة قطعة من الأرض مربعة الشكل قياساتها 180 م × 180م، محاطة بسور مدعم بأبراج نصف دائرية مبنية بالآجر والجص عرضه 1,50م المتبقية منها يتراوح ما بين (0/50-1م).
روعي التخطيط العام للأبنية أن يكون متناسباً مع موقعها في باطن الأرض بعمق (13م) عن مستوى الأرض، وتم اختيار بقعة من الأرض بداخل القصر تتلأم مع مساحة البركة ومع تخطيطها ذي الطابع الحيري المتطور.
إن وجود أبنية بعمق (13م) في باطن الأرض ظاهرة عمارية جديدة في العمارة العربية الإسلامية، كما انه وضح عنصر التماثل والتناظر الهندسي في عمارتها، إن الكشف عنها ووجود معالمها ساعدنا على وضع مخطط يختلف عن المخططات التي وضعها هر تسفيلد وفيوله وكانت نتيجة هذا اختلاف الوصف عموماً .
تنقسم أبنية البركة إلى قسمين:
القسم الأول: يحتوي على الأبنية العليا، أي الأبنية التي أقيمت على مستوى سطح الأرض الأصلية، والتي لم يتم التنقيب بها.
أما القسم الثاني، فيحتوي على حوض المياه والقاعات المستطيلة والأواوين والعناصر الأخرى التي تحيط بالحوض تبلغ مساحتها (14,000م2)، موجودة في باطن الأرض بعمق (13م) ، وهي التي نحن بصدد الحديث عنها، ويبدو لنا من خلال نظرة عامة على هذا القسم الذي تم الكشف عنه أن أبنيتها من الخارج عبارة عن شكل هندسي متعدد الأضلاع عدد أضلاعه 20 ضلعاً مختلفة القياسات، تؤلف أربع واجهات رئيسة يتخللها أربعة مداخل رئيسة وثمانية مداخل فرعية.
أما المسافة من الجدار الشمالي إلى الجدار الجنوبي (122/5م)، والمسافة من الجدار الشرقي إلى الجدار الغربي (123/5م) ، يتحول هذا الشكل من الداخل إلى
ص: 378
شكل دائري قطره (62م)، ويزيد عمقه عن عمق أرضية أبنية البركة بمترين، يحيط به ممر دائري (1)عرضه (7م) ، والمساحة المحصورة بين الشكل الدائري (حوض المياه، والشكل الهندسي المتعدد الأضلاع عبارة عن أبنية لعناصر عمارية عديدة منها قاعات يتقدمها أواوين على الطراز الحيري المتطور، زينت جدرانها بزخارف جصية تمثل طراز سامراء الأول، عدد هذه القاعات في الواجهات الأربع 20 قاعة مختلفة القياسات والزخارف والأرضيات كلاً حسب أهميتها، أما الزوايا فنجد فيها حمامات مختلفة القياسات ومرافق صحية.
المداخل : -
فتح في جدران البركة مداخل عديدة ومتنوعة تربط بين هذا الجزء والجزء العلوي منها .
المداخل الرئيسة : عددها أربعة مداخل نجد في كل واجهة مدخلاً مستطيلاً طوله(5/20م) وعرضه (2,80م)، يؤدي إلى سلّم هابط إلى الجزء الأسفل بعرضه (2/20م)، وعدد درجاته 47 درجة ، ويبلغ ارتفاع الدرجة الواحدة 30 سم وعرضها 30 سم، ينتهي هذا السلّم بباب عرضه (20 ، 2م). وسقّف هذا السلم بقبو 2(2).
المداخل الفرعية: عدد هذه المداخل ثمانية، اثنان منها في كل واجهة، ويوجد سلّمان مزدوجة في الواجهة الشمالية أحدهما على شكل منحدر والآخر سلّم درج يؤديان إلى مدخل واحد والمخطط رقم (1) واللوحة رقم (8) ، تعمل هذه المداخل على ربط المرفق العلوي بالمرفق السفلي عن طريق ممر منحدر ، ونلاحظ أن المدخلين مزدوجان يؤدي أحدهما إلى ممر منحدر والثاني إلى سلّم (درج) عرض الممر (1,70م) .
ص: 379
الوصف المعماري
الواجهة الشمالية
بعد إجراء التنقيب ظهر أن جدرانها تمتد من الشرق إلى الغرب بطول (80م) وبعمق (13م) عن مستوى الأرض البكر، مبنية بالآجر قياس (6×28×28سم) والجص الذي استخدم كمادة رابطة في تغليف أوجه الجدران من الداخل والخارج وزخرفة الجدران ، يمكن الوصول إلى عناصر هذه الواجهة عن طريق السلم الرئيس الهابط من المرفق العلوي الشمالي كما يتضح في اللوحة رقم (7) ، ويتقدم هذا السلم من أعلى جهة الشمال مدخل مستطيل الشكل طوله ( 4 م ) وعرضه (3م)، بلطت أرضيته بطابوق فرشي قياس (3×30×30سم) ، وزينت جدرانه على ارتفاع (1/5م) بزخارف جصية تمثل طراز سامراء الأول تمثل أوراق وعناقيد العنب كما يتضح في اللوحة (8) يتوسط جداره الجنوبي باب عرضه (2/20م) ، يفتح على السلم الهابط من السلم مدخل عبارة عن ثلاثة أواوين أكبره اتساعاً وارتفاعاً والأواوين الأوسط (الصدد) عرضه (2/20م) وطوله (2/20م) وارتفاعه (13م)، يتفتح على الرواق (الموزع ) (1) بارتفاع (3/80م) . انظر اللوحة رقم (9) .
بينما عرض الإيوان الأيمن (1/75م) (2) ، وطوله (3/60م)، وارتفاعه 2م، يفتح على الرواق (الموزع) بباب عرضه (1,40) ، وبارتفاع (2)، أما عرض الإيوان الأيسر (1/75م) وطوله (3/60م) وارتفاعه (2) ، يفتح على الرواق بباب عرضه
ص: 380
(1/20م) وبارتفاع (2م).
يجد الواقف بالموزع عن يمينه مدخلاً فرعياً بعرض (1,70م)، يؤدي إلى القسم الأعلى من البركة من ناحية الغرب عن طريق ممر منحدر تجاه الغرب، وعلى مسافة (16م) من المدخل تجاه الغرب، يجد الصاعد عن يساره باباً عرضه (10م) يؤدي إلى سلّم صغير عدد درجاته (3) درجة تجاه الجنوب، ثم ينعطف إلى اتجاه الغرب بعرض أكبر من عرض السلم الأول، حيث عرضه (1,70م) وعدد درجاته (31) درجة، ارتفاع الدرجة (30سم) ، وعرضها (30سم) ، ويتضح ذلك على اللوحة رقم (8).
أما عن يسار الواقف بالموزع فيجد المدخل الفرعي الثاني شرقاً عبارة عن منحدر بعرض (1/70م) يؤدي إلى القسم العلوي الشرقي من البركة.
بالعودة إلى أقسام الواجهة يستطيع الواقف بالموزع الوصول إلى جميع أقسام البركة عن طريق ثلاثة أبواب، حيث يجد أمامه باباً عرضه (2/60م) يؤدي إلى القاعة الرئيسة (1)رقم (1) ، مستطيلة الشكل طولها (10/40م) وعرضها (6/20م)، يتقدمها إيوان طوله (10/60م) عرضه (5/20 م) ، يفتح على حوض المياه الدائري مباشرة، وبلطت أرضيته بطابوق مقاس ( 5×50× 50 سم ) ، وزينت جدرانه بزخارف جصية كما هو في القاعة الرئيسة رقم (1). انظر اللوحة رقم (9)
يجاور هذه القاعة من جهة الغرب وعلى نفس الامتداد القاعة رقم (2) مربعة الشكل بارتفاع (13م) ، مساحتها (16م) ، يتقدمها من جهة الجنوب إيوان مستطيل الشكل طوله (10م) وعرضه ( 4 م ) ، يربط بينهما باب عرضه (1/70م)، ويفتح الإيوان على الممر الدائري بمدخل مستطيل الشكل طوله (2/60م) وعرضه (1/70م) على جانبيه الأيمن والأيسر جلستان ارتفاع كل منهما ( 40 سم ) وعرضها (2/20م) وطوله (3/20سم) متشابهتان .
ص: 381
يجاور هذه القاعة من جهة الغرب قاعة رقم (3) مستطيلة طولها (14/80م) وعرضها (4/10م) ، يوجد في جدارها الجنوبي ثلاث حنايا، أما الجانب الخلفي لهذا الجدار فتوجد حنية، يجاور هذه القاعة من جهة الغرب بقاعة رقم (4) هي مستطيلة الشكل طولها (11,80م) وعرضها (10، 4 م ) ، يصل إليها عن طريق باب عرضه (45، 1م) في الجدار الفاصل بينهما وبين القاعة رقم (3) من الجانب الشمالي له، يجاور هذه القاعة من جهة الجنوب حجرة مختلفة المقاسات طول جدارها الشرقي ( 3/20م ) والغربي (4/60م) والشمالي (4/10م ) والجنوبي ( 4/40م)، يصل إليها عن طريق باب يتوسط الجدار الفاصل بينها وبين القاعة رقم (4) ، عرضه (1,50م)، وكذلك عن طريق باب آخر عرضه (1م) يربط بينهما وبين القاعة رقم (3).
نلاحظ أن أرضية هذه الحجرة بلطت بطبقة من القير سمكها (5سم)، ويتوسطها فتحة بالوعة تؤدي إلى ساقية مياه طليت جدرانها بمادة النورة والرماد إلى ارتفاع (1م) من مستوى الأرضية.
ويوجد في جدارها الغربي باب عرضه (1) يصل الموزع المشترك بين هذه الواجهة والواجهة الغربية.
أما الجانب الشرقي من القاعة الرئيسة رقم (1) ، وعلى نفس الامتداد فنجد قاعة رقم (5) يمكن الوصول إليها عن طريق باب عرضه (1,50م) يفتح على الموزع، هي مربعة الشكل (4×4م) ، مساحتها (16م2) ، يتقدمها إيوان مستطيل الشكل طوله (9/40 م) وعرضه ( 4/10 م ) ، يصل إليه عن طريق باب عرضه (1,50م)، يتوسط الجدار الفاصل بينهما، ويفتح هذا الإيوان على الممر الدائري بمدخل مستطيل الشكل طوله (2/60م) وعرضه (1/70م)، على جانبيه الأيمن والأيسر جلستان ارتفاع كل منهما (40سم) وطولها (2,60م) وعرضها (1/60م).
ويجاورهما من جهة الشرق على نفس الامتداد قاعة رقم (6) مستطيلة الشكل
ص: 382
طولها (11/60م) وعرضها (5/20م9 ، تفتح باب عرضه (1،80م) على الإيوان طوله (5م) وعرضه (3م) يجاورها من جهة الجنوب هذا الإيوان يفتح على الممر الدائري بمدخل مستطيل الشكل يشبه بقية المداخل .
ويجاورها من جهة الشرق على نفس الامتداد إيوان مستطيل الشكل طوله (18م) وعرضه (2/20م) ، يصل إليه بواسطة باب عرضه (1,50م) في الجدار الفاصل بينه وبين القاعة رقم (6) ، يتقدم هذا الباب من الداخل بئر قطره (1/50م) وعمقه (6م) ويتخلل جداره الشرقي باب عرضه (1/20م) يؤدي إلى مدخل مستطيل طوله (2م) وعرضه (1/40م) ، يصل منه الداخل إلى الممر المنحدر الشرقي عن طريق سلم عدد درجاته (7) درجات اتساعه (1,70م) ، ارتفاع الدرجة (30 سم) وعرضها (30سم) ، ويوجد في جداره الجنوبي حنية وفي الجانب الشرقي يوجد باب عرضه (1م) يؤدي إلى الموزع بين تلك الواجهة والواجهة الشرقية.
الواجهة الغربية : -
هذه الواجهة لا تختلف عن الواجهة الشرقية من حيث التخطيط وعدد القاعات والأواوين والزخارف الأرضية، لكن أهم ما يميز الواجهة الغربية، (لوحة رقم 10) الجدران الإضافية وكهريز المياه الذي يخترقها من الشرق إلى الغرب ووجود أبراج متنوعة تتخلل الجدران الملاصقة للسد الصخري (الواجهة الخارجية لأبنية البركة) كما يتضح في اللوحة رقم (11).
1 - الجدران الإضافية : انفردت الواجهة الغربية عن نظائرها من الواجهات الثلاث الأخرى بوجود جدار إضافي ملاصق للجدار الغربي الملامس للسنّ الصخري مبني بالطابوق والجص ، يتخلله عدد من الأبراج مدرّجة - حيث نلاحظ في الجدار بصفة عامة ارتداد البناء كلما ارتفع عدد الأبراج (2) بارتفاع (13م) ، تدعم الجدار الأساسي وتخلل الجدار الإضافي عدة ارتدادات في الأبراج والجدار ترتد باتجاه
ص: 383
الغرب مسافة الارتداد في نهاية الارتفاع (1/20م)، أي الفرق بين أساسي الجدار وقمة ارتفاعه، ولعل هذا يدعم الجدران كما يضفي عليها جمالاً، وسبب وجودها لتدعيم تلك الواجهة خوفاً من تصدعها نظراً لضعفها، حيث نلاحظ في بعض المناطق الطبيعية الجصية نفذت على السن مباشرة، ولعل نفوذ الكهريز وسط هذه الواجهة له علاقة إنشائية للجدران الإضافية عرض الجدار (1/10م) ، ونتج عن هذا الجدار إلغاء الممرين الفرعيين بهذه الواجهة.
كذلك وجدت جدران إضافية في الجدار الشمالي لهذه الواجهة كما يتضح في اللوح رقم (11)، هذا الجدار أيضاً مبني من الآجر والجص عرضه (1/10م)، يتخلله برجان ذوا قواعد مربعة وعدد درجاته 47 درجة، ويبلغ ارتفاع الدرجة الواحدة 30 سم وعرضها 30 سم ينتهي هذا السلم بباب عرضه (2،20م) . يعلوها بدت أسطواني أيضاً تظهر الإضافات في الجدار الجنوبي منها . اللوحة (12) .
لوحة رقم (13) يخترق الواجهة كهريز متجه غرباً إلى نهر دجلة.
بالعودة مرة ثانية إلى الوصف العماري يتقدم الواجهة الغربية مدخل مستطيل الشكل طوله (2/50م) وعرضه (2/20م) يربط بين المرفق العلوي والسفلي حيث يؤدي إلى سلّم عرضه (2,20م) عدد درجاته 47 درجة وارتفاع الدرجة (30سم)، وعرضها ( 30 سم ) يؤدي إلى مدخل - حيث يتكون من ثلاثة أواوين أكبرها وأعلاها ارتفاعاً الإيوان الأوسط (الصدر) طوله (2/20م) ، وعرضه (2/20م) ، وارتفاعه (3,80م) ، يفتح على الموزع بكامل اتساعه، أما الإيوان الأيمن طوله (4م) وعرضه (1,50م) وارتفاعه (2م) ، وكذلك الإيوان الأيسر طوله (4) وعرضه (1,50م) وارتفاعه (2م). وإن أبوابها التي تفتح على الموزع ألغيت بسبب الجدران الإضافية التي سبق ذكرها، وهي كانت تفتح على الموزع الذي طوله (6/20م) وعرضه (4,20م).
ص: 384
ويمكن الوصول إلى جميع قاعات وأواوين الواجهة بواسطة ثلاثة أبواب، حيث يتوسط جداره الشرقي باب عرضه (1,80م) يؤدي إلى القاعة رقم (1) الرئيسة، طولها (10,80م) وعرضها (6/20م) ، يتقدمها إيوان من جهة الشرق طوله (1/40) وعرضه (5/20) ، يفتح على حوض المياه، بلطت الأرضيات بطابوق قياس (50×50×5 سم ) ، وزينت الجدران بارتفاع (1م) بزخارف جصية تمثل طراز سامراء الأول انظر اللوحة رقم (9).
يجاورها من جهة الشمال على نفس الامتداد قاعة رقم (2) طولها (4/10م) وعرضها (4/20 م) ، تتصل بالموزع السالف الذكر بواسطة باب عرضه (1,40م) ، ويتقدمها من جهة الشرق إيوان طوله (9/80م) وعرضه (4/20م) ويتم الوصول إليه بواسطة باب عرضه (1,80م) ، يتوسط الجدار الفاصل بينهما كما انه على الممر الدائري بمدخل طوله (2,60م) عرضه (1,70م) ، على جانبيه الأيمن والأيسر دکتان متشابهتان بارتفاع (0/40 م) ، وطوله (2,60م) وعرضه (2/60م)، كما يوجد في الجانب الشمالي وعلى نفس الامتداد قاعة رقم (3) مستطيلة الشكل طولها (11/60م) وعرضها (5/20 م ) ، يتم الوصول إليها بواسطة باب عرضه (1/50م) في جدارها الجنوبي.
كما يتوسط جدارها الشرقي باب عرضه (1,70م) يؤدي إلى الإيوان الذي يتقدمها مستطيل الشكل طوله (5,20م) وعرضه (3م)، ويزين جداره الشرقي ثلاث حنايا، ويتخلل جداره الشمالي باب عرضه (1,20م) ، يؤدي إلى ممر (مخزن) طوله (19م) وعرضه (3م) ، أما الجانب الأيمن من القاعدة الرئيسة وعلى نفس الامتداد تجاه الجنوب توجد قاعتان يتقدمها إيوانان رقم (4،5 ) ويجاورهما من جهة الجنوب ممر (مخزن) رقم (6) .
يتم الوصول من الموزع إلى القاعة رقم (4) عن طريق باب عرضه (1/70م) في جدارها الشمالي، وهي مربعة الشكل مساحتها تساوي (16م2)، تتصل بالإيوان
ص: 385
الذي يتقدمها عن طريق باب عرضه (1/50م)، مستطيل الشكل طوله (9/80م) وعرضه (4,20م) ، يفتح على الممر الدائري بمدخل عرضه (1,70م) وطوله (2/60م)، على جانبيه الأيمن والأيسر دكتان متشابهتان بارتفاع (40سم) وطوله (2/60 م) وعرضه (2/40م) .
أما القاعة رقم (5) يتم الوصول إليها عن طريق باب عرضه (1,50م) في جدارها الشمالي مساحتها تساوي (4/8 +x3/8) م2 (1) .
يتوسط جدارها الشرقي باب عرضه (1م) يؤدي إلى الإيوان رقم (6) الذي مساحته (4/11 80/4م) ، ويزين جُداره الشرقي ثلاث حنايا، في جداره الجنوبي باب عرضه (1) م يؤدي إلى مخزن مستطيل الشكل، حيث طوله (11,50م) وعرضه (220م) ، وعن طريق هذا الممر من الجانب الشرقي نصل إلى العنصر العماري رقم (2). انظر اللوحة (14).
الواجهة الجنوبية -
بالنظر إلى المخطط رقم (1) يتضح لنا أنها لا تختلف عن الواجهات الأخرى، وأهم ما يميزها:
الحمام الموجود في الركن الجانبي الشرقي منها.
الحالة الجيدة التي وضحت في المدخل الفرعي الغربي والمدخل الرئيس انظر اللوحة رقم (15) . والمخطط رقم (2)، حيث يعتبران من أهم النماذج الأثرية المتكاملة والتي تساعد في إعادة الصيانة على الطابع الأثري القديم، تمتد من الشرق
ص: 386
إلى الغرب بطول (83م) وبعمق (13 م) (1)، يتم الوصول إلى عناصر هذه الواجهة عن طريق المدخل الرئيس للمداخل الفرعية.
المدخل الرئيس:
طوله (60, 5م) عرضه (2,80م) يربط بين المرفق العلوي... والسفلي من البركة حيث يؤدي إلى سلم، وينتهي هذا السلم بمدخل يؤدي إلى ثلاثة أواوين أكبرها عرضاً وأعلاها ارتفاعاً الإيوان الأوسط (الصدر). حيث نجد عرضه (2/20م) وطوله (2/20م) وارتفاعه (13م) يفتح على الموزع بكامل عرضه (2/20م) وبارتفاع (3,80م).
أما الإيوان الأيمن، عرضه (1/75م) ، طوله (4/80م)، ارتفاعه (2/20م)، ويفتح على الموزع بباب عرضه (1/40) وارتفاعه (2/20م)، والإيوان الأيسر عرضه (1,75م) وطوله (4,80 م ) وارتفاعه (2/20م) ، يفتح على موزع قياس (4× 6 م) بباب عرضه (1,40م) وارتفاعه (2/20م) . يتوسط جداره الشمالي باب عرضه (1,80م) ، يؤدي إلى القاعة رقم (1) الرئيسة طولها (1,80م) وعرضها (6,20م) ، يتقدمها إيوان طوله (10/60م) وعرضه (5,20م) على حوض المياه الدائري مباشرة، يجاورهما من جهة الغرب قاعة رقم (2) ورقم (3) والممر المخزن رقم (4) القاعة رقم (2) طولها (4/20م) وعرضها (10/4م) تتصل بالموزع بواسطة باب عرضه (1/20م) يتخلل جدارها الشرقي.
وتفتح على الإيوان الذي يتقدمها بباب عرضه (1/80م) أما طول هذا الإيوان (9/80م) وعرضه (4/20م) يفتح على الممر الدائري بمدخل عرضه (1,70م) وطوله (2,60م)، يحيط من الجانبين دكتان متشابهتان بارتفاع (40سم) وبطول
ص: 387
(2/60م) وعرض (2/60م) القاعة رقم (3) مربعة الشكل مساحتها (16م) مربع تتصل بالقاعة رقم (4) بباب عرضه (120م) ، يفتح في جدارها الشمالي باب عرضه (1م) يؤدي إلى الإيوان الذي طوله (11/80م) وعرضه (4,60م ) .
يزين جداره الشمالي ثلاث حنايا، ويفتح في جداره الغربي من جهة الشمال باب عرضه (1/50م) يؤدي إلى الممر رقم (4) طوله (18/80) وعرضه (2,40م)، يوجد في نهايتها من الجهة الجنوبية أرضية حمام ( عليها طبقة من القير يتوسطها فتحة تتصل بالكهريز الفرعي)، مساحة أرضية الحمام (2/20×2/40م)، ويفتح هذا بمدخل عرضه (1,70م) وطوله (2/60م)، على جانبيه دكتان متشابهتان بارتفاع (0/40م) وطول (2/60م) وعرض (80).
أما الجانب الشرقي الأيمن من القاعة الرئيسة قاعة رقم (5) طولها (4/20م) وعرضها (4/20م) تتصل بالموزع بباب عرضه (1/50م). وتفتح على الإيوان الذي يتقدمها باب عرضه (1,80م)، طول هذا الإيوان (9/20م) وعرضه (4/40م)، ويفتح على الممر الدائري بمدخل على غرار المداخل السابقة، ويجاورهما من جهة الشرق قاعة رقم (6) طولها (12,50م) وعرضها ( 5/20م) يتم الوصول إليها بواسطة باب ي عرضه (1,50م) في جدارها الغربي، وتفتح هذه القاعة على الإيوان بباب عرضه (1,80م)، أما طول ذلك الإيوان (5م) وعرضه (3/60م) يزين جداره الشمالي حنايا تفتح في جداره الشرقي باب عرضه (1/50م) من جهة الشمال، وآخر عرضه (1,50م) من الجانب الجنوبي، كلاهما يؤدي إلى أبنية الحمام.
الواجهة الشرقية
في 15 شباط 1989م واصلت الهيئة أعمالها في الواجهة الشرقية حتى تبين لنا جميع عناصرها العمارية التي تختلف عن الواجهات الثلاث السابقة سواء من حيث التخطيط والمساحة، وعدد القاعات وعدد الأواوين ومواد البناء، والأرضيات
ص: 388
والزخارف.
أهم ما يميزها عن باقي الواجهات هو الكهريز الذي يغذي البركة بالمياه، والذي تم اكتشافه في 4 آذار 1989 . انظر اللوحة (17) اتساعه (70سم) وبعمق (1/10م) ، يمتد بطول (82م) في باطن الأرض وعمقه (13م) تحت مستوى سطح الأرض يعلوه مدخل رئيس طوله (5/30م) وعرضه (2,80م) يؤدي إلى سلم عدد درجاته 47 درجة، ارتفاع الدرجة (31 سم) وعرضها (30سم)، ينتهي السلم من الأسفل بباب عرضه (2/20م)، يؤدي إلى مدخل يتكون من ثلاثة أواوين أكبرها وأعلاها الإيوان الأوسط، طول ضلعه (2/20م) ، الموزع ارتفاعه (3/80م)، أما الإيوان الأيمن طوله (3/60م) وعرضه (1/75م) ارتفاعه (2/20م) يفتح على الموزع بباب عرضه (1/20م) ، الإيوان الأيسر طوله (2،60م) وعرضه (1،75م) و ارتفاعه (2/20م) ، يفتح على الموزع بباب عرضه (1/40م)، بالإضافة إلى هذا المدخل الرئيس نجد مدخلين فرعيين أحدهما في الجانب الشمالي، والآخر في الجانب الجنوبي، يؤديان إلى المزود بواسطة ممر منحدر عرضه (1,70م).
أما مساحة الموزع طوله (6م) وعرضه (4 م) ، بلطت أرضيته بطابوق قياس (5×50×50سم) وزينت الجدران بزخارف جصية تمثل طراز سامراء الأول انظر اللوحة رقم (9).
الوصول إلى القاعات عن طريق ثلاثة أبواب، الباب الأوسط عرضه (1,80م) قد يؤدي إلى القاعة الرئيسة رقم (1) طولها (11م) وعرضها (620م) ، هذا الإيوان يفتح مباشرة على حوض المياه بلطت أرضيته بطابوق قياس (5×50× 50سم)، وزينت الجدران بزخارف جصية بديعة تمثل طراز سامراء الأول.
يجاورهما من جهة الشمال القاعة رقم (2) طولها (4/40) وعرضها (4/10م)، يمكن الوصول إليها عن طريق باب عرضه (1/45م) ، يفتح هذا على الموزع ، يتقدم
ص: 389
هذه القاعة إيوان طوله (9/40م) وعرضه (4/10) ، يفتح هذا الإيوان على الممر الدائري بمدخل طوله ( 2/60م) وعرضه ( 4/10 م) ، يفتح هذا الإيوان على الممر الدائري بمدخل طوله ( 2/60م) وعرضه (1/70م) ، على جانبيه دكتان ارتفاع كل منهما ( 40سم) الطول (2,60م) العرض (2/20م) ، يجاورهما من جهة الشمال قاعدة رقم (3) طولها ( 10, 5 م ) وعرضها ( 3,40م) ، يتقدمها من جهة الغرب إيوان طوله (12م) وعرضه (3/40م)، ويزين جداره الغربي ثلاث حنايا، يجاورها من جهة الشمال وعلى نفس الامتداد قاعة طولها (12,40م) وعرضها (3/40م)، يتوسط القاعة ( مرافق صحية)، بلطت الأرضية بالقير تؤدي إلى العنصر العماري المشترك بين هذه الواجهة والواجهة الشمالية.
وبالعودة إلى القاعة الرئيسة نجد يجاورهما من جهة الجنوب قاعة رقم (5) طولها (4/40م) وعرضها (4/10م) ، يتقدمها إيوان طوله (9/20م) وعرضه (4/10م)، يفتح على الممر الدائري بمدخل طوله (2,60م) عرضه (1,70م)، على جانبيه دكتان متشابهتان بارتفاع ( 40 سم ) طول (2/60م) وعرض (2,60م).
يجاورهما من جهة الجنوب قاعة رقم (6) طولها (11,80م) وعرضها (5م)، يتقدمها إيوان طوله (5م) ، عرضه (4م) . يتم الوصول إليه بواسطة باب عرضه (170م ، يزين الجدار الغربي من هذا الإيوان ثلاث حنايا(1)، وعن طريق باب عرضه (1/70م) ، يتخلل جداره الجنوبي نصل إلى مخزن يؤدي إلى الحمام.
تصريف مياه البركة
أما عن تصريف المياه من البركة يؤكد من خلال التنقيبات التي أجريت خلال عام 1988م ام ما يقوله الدكتور أحمد سوسة: (أما المياه الزائدة التي كان لابد من
ص: 390
خروجها إلى مكان واطئ فكانت تصرف إلى نهر دجلة في كهريز يبدأ من حافة البركة الأخيرة وينتهي عند نهر دجلة) (1).
هذا هو الذي تم تأكيده ليظهر قمة الإبداع الهندسي الذي وصل إليه المعمار في عهد الخلفاء العباسيين في سامراء ، ولعل هذا الكهريز ما يزيد من قمته انه منقور وسط الصخر وبارتفاع متفاوت من مسافة إلى أخرى، وتدرج انخفاض الأرضية كلما اتجه باتجاه الغرب، فهو يبدأ من حافة الاستدارة لحوض المياه الدائري من الجانب الغربي ويمتد مسافة (31/5م) حتى بداية السن الصخري، ويتقدمه لوحان من الرخام في أرضية حوض المياه اتساع كل منهما (70سم)، أما الكهريز نجد انه يخترق القاعدة الرئيسة من الوسط تحت الأرضية، يحاط من الجانبين بجدارين يحصران بينهما مسافة باتساع (70سم) ، والارتفاع من أرضية الكهريز إلى بداية أرضية القاعات (1,70م) ولغرض منع تسرب المياه وزيادة قوتها جعل أنابيب فخارية متصلة ببعضها بطول (31/5م) ، والأنابيب شكلها اسطواني انظر اللوحة رقم (16) طولها (90سم) وقطرها (35سم) ، وتنحصر وسط الجدران السابق ذكرها وتنتهي إلى بداية السن الصخري.
ومن بداية السن الصخري نجد الكهريز بعرض (1م) وارتفاع (4/60م) مع انحدار الأراضي كلما اتجهنا غرباً، حيث يسير على هذا الاتساع والارتفاع لمسافة (34/50م) ، وفي نهاية المخطط رقم (3) نجد المسافة من النقطة ( ب : ج_) تختلف عن المسافة السابق ذكرها من حيث الارتفاع، نجد انه ينخفض حتى يصبح (3,30م).
أما من حيث العرض فهو لا يختلف من حيث الأرضية نجد انحداراً قليلاً كلما اتجهنا غرباً طول هذا المسافة (7م) م ، ومن النقطة (ج_: د) نجد اختلافاً عن المسافة السابقة حيث نجد انخفاضاً كبيراً في الارتفاع مع انخفاض في الأرضية والعرض في المساحة ، فنجد الارتفاع يبلغ (80م) والعرض (1,53م) طول هذه المسافة (7)،
ص: 391
وتنخفض عن مستوى أرضية المسافة السابقة ب_ ( 50م) . أما المسافة من النقطة (د: ه_) النقطة التي وصلنا إليها في العمل تختلف عن المسافات، فمن حيث الارتفاع (170سم) والعرض (1/10م) ، والانخفاض بالنسبة للأرضية المسافة السابقة (80م)، وهذه المسافة تميل باتجاه الجنوب الغربي قليلاً طولها (12م) ، ولقد وجد هذا الكهريز مليئاً بالأتربة فقمنا بعملية التنظيف حتى توصلنا إلى نقطة ( ه_ ) السابق ذكرها، أي إلى مسافة (93م) من حافة حوض المياه الدائري باتجاه الغرب.
أثناء عملية التنقيب تم العثور على العديد من اللقى الأثرية التي جرفتها المياه، فعثرنا على مسرجة فخارية على مسافة (35م) باتجاه الغرب في الكهريز، وعدد من القناني الزجاجية.
أما الكهريز الفرعي والخاص عندما يلاقي بداية الكهريز الرئيس انظر المخطط رقم (1) حيث توضح عليه الاتجاهات، فنجد أنه في نهاية الحمام من الجانب الغربي يتفرع إلى فرعين أحدهما يتجه إلى اتجاه الشمال ناحية حوض المياه الدائري، يتوسطه حفرة عميقة عمقها ( 1,50م) وعرضها ( 1,50م) ، لعلها عملت خصيصاً لتسريب ما يتعلق بالمياه الثقيلة .
والفرع الثاني يتجه جنوباً بمسافة (2م) ، ثم ينكسر باتجاه الغرب حتى نهاية الواجهة الجنوبية، حيث ينكسر باتجاه الشمال حتى بداية الممر الدائري للبركة، فنجده يتجه تجاه الشمال الغربي حتى يتلاقى مع الكهريز الرئيس.
مواد البناء
إن من أبرز مواد البناء المستعملة في الجدران هو الآجر مع مادة الجص المستعملة للربط، قياسات القطعة الواحدة (8×28×28سم).
بالنسبة إلى الجزء العلوي من الجدار فإنه كان مغطى بطبقة جصية سواء كان مزخرفاً أم غير مزخرف، حيث استخدمت زخرفة جدارية تغطي القسم الأسفل من
ص: 392
الجدار، إلى ارتفاع يتراوح بين (1/30-1/50م)، وهذا تركز في القاعات الرئيسة والاواوين التي تتقدمها وجميع الموزعات وهي تمثل طراز سامراء الأول، في حين استخدمت أشرطة بسيطة على شكل عضادات تحيط بجانبي الأبواب وأحياناً نجدها في وضع أفقي في القاعات الجانبية، كما أن للأخشاب دوراً كبيراً في تثبيت وتقوية البناء نفسه من خلال استخدامها مع مواد البناء وظهر هذا في الواجهة الشرقية ، هذا إضافة إلى كونها من مواد الزخرفة المهمة واستخدمت في التسقيف أيضاً.
أما الأرضيات كانت مغلفة بالآجر قياس (5×500×5سم) وضح ذلك في القاعات الرئيسة والممر الدائري. وفي بعض الأحيان نجد قياسات أخرى (3×30×30سم) في القاعات الجانبية من الواجهات، استخدمت مادة الجص في الأرضيات ممزوجة مع قطع الجص الصغيرة في العناصر العمارية المشتركة والقاعات الجانبية وكذلك الأواوين الجانبية.
مادة القير استخدمت في تبليط الحمامات والمرافق الصحية لكونها مانعة للرطوبة، واستخدمت مادة النورة والرماد في أسس الجدران بصفة عامة.
أما أرضية حوض مياه البركة الدائرية فهي تختلف عن أرضيات العناصر العمارية وذلك استخدم عدد (11) صفاً من الطابوق سمكها (30سم)، ويتضح ذلك في المخطط رقم (2) واللوحة (17)، وقام بتغليف حافة حوض المياه بألواح من المرمر قياس (5×15×30سم) لمنع تسرب المياه خاصة وان تربة سامراء بصفة عامة كلسية تعمل على تسرب المياه، لوحة (18)، (19).
تغذية البركة بالمياه
قبل الحديث عن مصادر تغذية البركة بالمياه لابد ان نعرف ان هذه المصادر نفذت قبل البدء في البناء، وكذلك مصادر تصريف المياه، لذلك ظهرت في أبدع صورها الهندسية.
ص: 393
الصورة
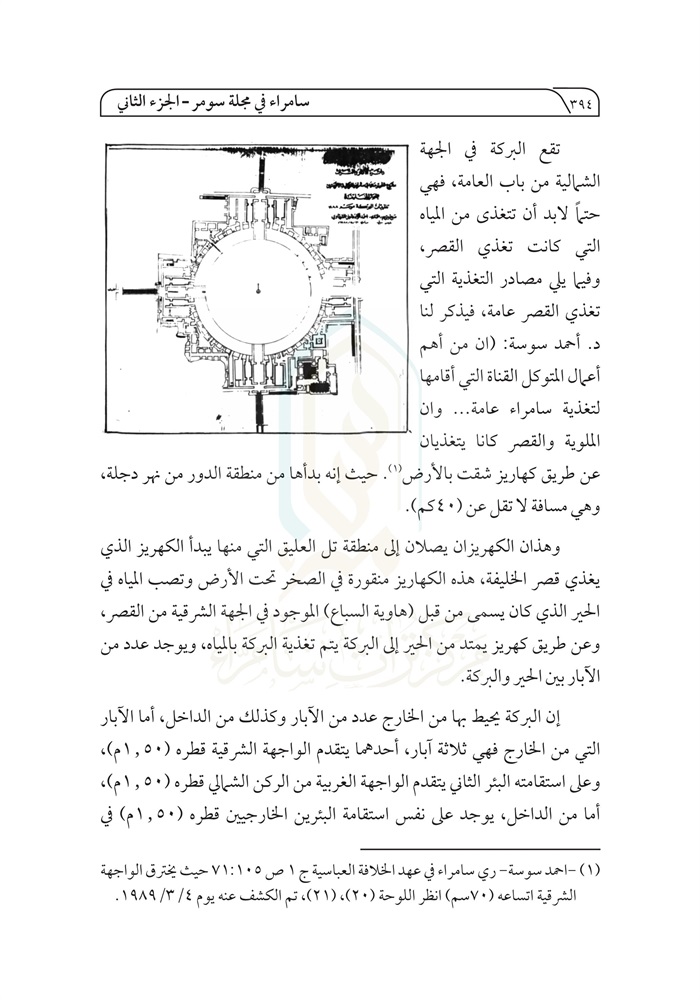
تقع البركة في الجهة الشمالية من باب العامة، فهي حتماً لابد أن تتغذى من المياه التي كانت تغذي القصر، وفيما يلي مصادر التغذية التي تغذي القصر عامة، فيذكر لنا د. أحمد سوسة: (ان من أهم أعمال المتوكل القناة التي أقامها لتغذية سامراء عامة... وان الملوية والقصر كانا يتغذيان عن طريق كهاريز شقت بالأرض (1) . حيث إنه بدأها من منطقة الدور من نهر دجلة، وهي مسافة لا تقل عن (40كم).
وهذان الكهريزان يصلان إلى منطقة تل العليق التي منها يبدأ الكهريز الذي يغذي قصر الخليفة هذه الكهاريز منقورة في الصخر تحت الأرض وتصب المياه في الحير الذي كان يسمى من قبل (هاوية السباع ) الموجود في الجهة الشرقية من القصر، وعن طريق كهريز يمتد من الحير إلى البركة يتم تغذية البركة بالمياه، ويوجد عدد من الآبار بين الحير والبركة.
إن البركة يحيط بها من الخارج عدد من الآبار وكذلك من الداخل، أما الآبار التي من الخارج فهي ثلاثة آبار أحدهما يتقدم الواجهة الشرقية قطره (1,50م)، وعلى استقامته البئر الثاني يتقدم الواجهة الغربية من الركن الشمالي قطره (1,50م)، أما من الداخل، يوجد على نفس استقامة البئرين الخارجيين قطره (1,50م) في
ص: 394
مقدمة الإيوان الشرقي من الواجهة الشمالية يوجد به مياه يتم استخدامها لأغراض البناء.
الصورة

ص: 395
الصورة
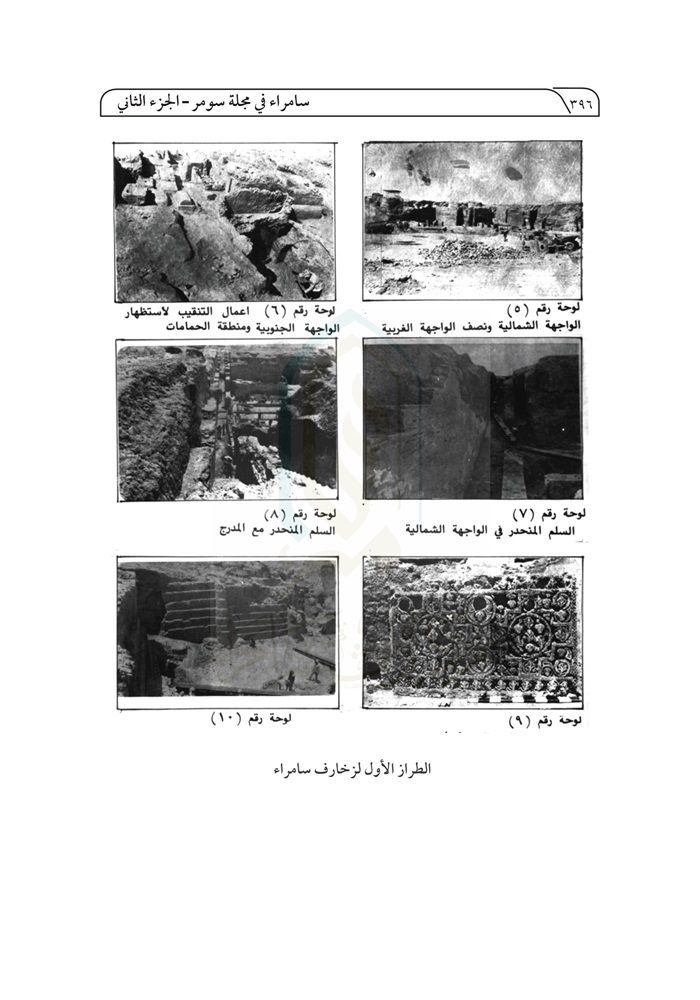
ص: 396
الصورة
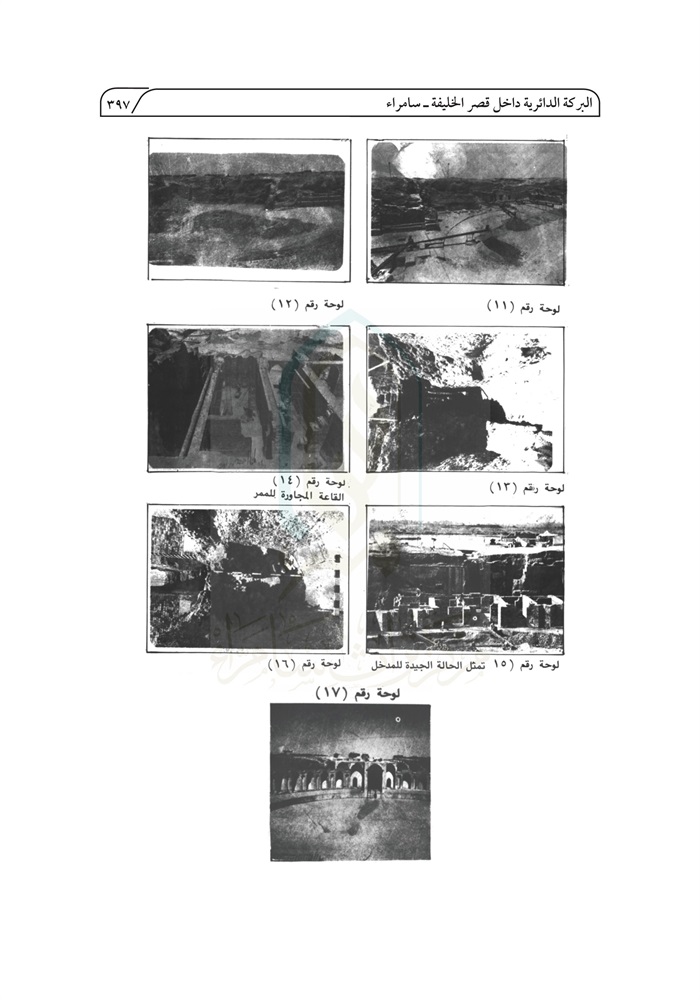
ص: 397
ص: 398
المجلد الخمسون سنة 1999 - 2000
عبد الرحمن محمد علي
اختصاص آثار
أسست مدينة سامراء سنة 221 ه_ - 836م في زمن الخليفة المعتصم بن هارون الرشيد، وهو ثامن الخلفاء بني العباس، وجعلها عاصمة جديدة للدولة العباسية، ثم وسعها أبناء الواثق، واوصلها إلى أوج عظمتها وأقصى اتساعها الخليفة المتوكل على الله من 22 - 247ه_) (1) (846-11ه_) ، إلا أن المدينة تركت بعد ذلك وأعاد المعتمد على الله مقر الخلافة إلى بغداد ثانية عام 267ه_ وأصبحت سامراء أثراً بعد أن كانت عيناً (2)ولم يكن قد مر عليها أكثر من نصف قرن.
إن قصة إنشاء مدينة سامراء بالسرعة التي أقيمت فيها ثم هجرانها على حين غرة من الأدوار التاريخية التي تستوقف نظر المؤرخين، إذ إن هذا الازدهار العجيب لم يستمر طويلاً؛ لأن المدينة تفقد صفة (العاصمة ) (3) ، التي كانت علة وجودها وعامل كيانها، قبل ان يمضي نصف قرن على نشأتها فتأخذ في الاقفرار والاندراس بسرعة هائلة، وبعد ان كان الناس يسمونها (سر من رأى)، أضحوا يسمونها (ساء من رأى) وعلى الرغم من قصر هذه الفترة التي عمرت فيها هذه المدينة فان عمرانها أحدث تطوراً غير مألوف في تاريخ العمارة والفنون الإسلامية (4).
ص: 399
يمكن القول بأن مدينة سامراء قد اجتازت مرحلتين في تاريخ إنشائها، المرحلة الأولى وتشمل الأعمال العمرانية التي قام بها المعتصم والواثق، أما المرحلة الثانية فتشمل التوسعات التي أضافها الخليفة المتوكل في زمن خلافته التي دامت 15 سنة.
أما الأعمال التي أنجزت في زمن المعتصم فهي تأسيس المدينة وتنظيمها، فقسم المعتصم المدينة إلى أحياء وقطائع أسكن في كل حي صنفاً من جيشه وعنى بعزل الجيش ودواوين الحكومة عن الأهليين، ويدل تخطيط المدينة على براعة فائقة في هندسة تخطيط المدن؛ إذ إن فيه كثيراً من الابتكار كما يجتلي ذلك في تنظيم الشوارع والمساكن وتنسيق الأبنية العامة والأسواق والمتاجر والمساجد والحدائق وحلبات السباق.
وقد بلغ طول البناء الذي أقيم في زمن المعتصم زهاء (19 كم طولا)، تتخلله عدة شوارع متوازية على طول هذه المسافة منها شارع الخليج بموازاة نهر دجلة، والشارع الرئيس الذي يعرف بشارع (السريجة) أو الشارع الأعظم.
ومن أهم العمارات التي كانت على شارع السريجة والتي لا تزال آثارها شاخصة (دارالخلافة) قصر الخليفة أو دار العامة (الجوسق الخاقاني) التي كان يجلس فيها الخليفة أيام الاثنين والخميس، وتقع هذه الدار إلى الشمال من مدينة سامراء الحالية بزهاء (2،5كم) على ضفة نهر دجلة اليسرى، ويبلغ امتداد واجهتها (700م)، أما المسافة بين واجهة الدار (باب العامة) وآخر أبنيتها من جهة الشرق فلا تقل عن (800م) ، إذ تقدر مساحة بنايات قصر الخليفة ومشتملاتها بما لا يقل عن مليون متر مربع في أيام ازدهارها في زمن المتوكل، حيث بدأت مرحلة جديدة في تاريخ سامراء بذلت فيها الأموال الكثيرة في إقامة المشاريع العمرانية وفي مقدمتها (قناة المتوكل) (1)، حيث جلب لها الماء من قناة خفية تستمد مياهها من نهر دجلة شمالي الدور، تستمر مسافة 40كم حتى تصل إلى قلب العاصمة سر من رأى، وبفضل هذه القناة تمكن
ص: 400
المتوكل من إيصال الماء إلى قصر الخليفة وإنشاء بركتي القصر (1)، إذ تقع البركة الأولى (البركة النهارية) في الجهة الشرقية من دار الخليفة في اتجاه محور الإيوان الكبير في باب العامة على بعد 600 م ، وقد سميت هذه البركة بأسماء مختلفة منها (الزندان) و (الهبية أو الهاوية) و (هاوية السباع)، التي تسمى اليوم بقصر الحير، ويعتقد بأن هذه البركة أنشئت لتحقيق غايتين أولاهما تأمين حوض سباحة الخليفة، والأخرى تأمين ملجأ صيفي يقضي فيه ساعات الحر أيام الصيف المحرقة، وجعل لها سقفاً من الخشب، ولم يكتف المتوكل بهذا المخبأ الذي اقتصر على أوقات النهار فعمل على إنشاء بركة أخرى ليلية مكشوفة يقضي فيها جلساته الليلية هكذا أنشأ بركة أوسع وأعمق من بركة ،السباع، وهي منقورة في الصخر وسط حفرة مدورة تقع إلى الجهة الشمالية الغربية من الحير، وكانت هذه البركة تستمد مياهها من بركة السباع من (كهريز ) يمتد بينهما، ويشاهد بين البركتين بئر مربع الشكل (شكل 1) تتصل بالكهريز المذكور لتنظيفه أو لغرض أخذ المياه منها للشرب، أو لحاجات أخرى، وإن هذا الكهريز هو الذي يغذي حدائق نافورات قصر الخليفة بالماء ومنها النافورة التي نحن بصدد دراستها.
لقد كانت منطقة قصر الخليفة محاطة بسور مساحتها (175 هكتاراً) من ضمنها (71 هکتاراً) تشغلها حديقة تواجه مع شرفاتها وأقبيتها وأحواضها نهر دجلة.
يبدو لنا إن اتخاذ هذه المساحة الشاسعة للقصر إنما كان بقصد توفير وسائل الراحة والتسلية واللهو للخليفة وحاشيته والمتمثلة في الساحات والبرك والنافورات وأحواض المياه والسراديب والأنفاق.
ص: 401
الرحبة الكبرى (1):
ساحة قصر الخليفة الكبيرة مساحتها الشاسعة تعطي انطباعاً يوحي بالعظمة، كما أن هناك بركاً ونافورات أخرى من الرخام (2)، وان هذه الرحبة كانت مقسمة بواسطة قناة (سرداب) إلى قسمين: غربي مرصوف بالآجر (لوح 1) من النوع الكبير المربع قياس (45×45×5سم ) ؛ إذ استخدم هذا النوع من الآجر في تبليط الساحات المكشوفة بشكل خاص(3) ، وإن هذا القسم مزدان بنافورتين الغربية منها هي موضوع هذا البحث، أما القسم الشرقي من الرحبة الكبرى فهو غير مرصوف تتخلله أقنية صغيرة، نلاحظ أن مؤلف كتاب «العمارة العباسية في سامراء» بسمي قصر الحير بالسرداب الصغير والبركة الدائرية الكبيرة بالسرداب الكبير على حد وصف المنقبين الألمان ومنهم كريسول(4).
قناة المتوكل:
كان أول مشروع قام به المتوكل بعد توليه الخلافة المشروع المعروف باسم (قناة سامراء)، الذي يؤمن إيصال المياه إلى عاصمته سامراء بطريقة الري الجوفي المعروف (ري الكهاريز ) ؛ ليتسنى له الابداع في تنسيق بناياته وقصوره وحدائقه ونافوراته والتوسع نحو الشرق دون أن يخشى الابتعاد عن ساحل النهر.
اشتمل هذا المشروع على كهريزين ضخمين يستعمل أحدهما في الشتاء والآخر في الصيف، وهما يستمدان مياههما من نهر دجلة حتى يصلان إلى العاصمة سر من رأى، وقد مد المتوكل هذين الكهريزين إلى الجنوب جوار القادسية.
وبفضل هذا المشروع تمكن المتوكل من إنجاز مشاريعه الجبارة في قلب
ص: 402
العاصمة ومن أهمها إنشاء حوض للسباحة خلف قصر الخليفة، ثم البركة الواسعة التي في الجهة الشمالية الغربية من بركة السباع.
إن القناة التي تتفرع من حوض التوزيع تتجه نحو سامراء، وكانت تمون مسجد الملوية بالمياه (وهو المسجد الجامع الذي أنشأه في أول الحير فيه على حسب قول اليعقوبي «فوارة ماء لا ينقطع ماؤها»)، كما انها تمون حلبة السباق حول تل العليق وخندقه بالمياه، وأخيراً كانت تلك القناة تمون بركتي قصر الخليفة بالماء، ولتحقيق هذه الأهداف شقت لها كهاريز فرعية من القناة الأصلية.
يقصد ببركة السباع قصر الحير الذي نقبه وقام بصيانته مشروع آثار سامراء الأعوام 1985 و 1986 (1)، أما البركة الليلية أو السرداب الكبير حسب قول المؤرخين العرب والأجانب فهي البركة الدائرية التي قام المشروع المذكور بالكشف عنها خلال تنقيبات سنة 1988 ، وقام بإعادة بنائها سنة 1989، حيث تم افتتاح (2) النافورة موضوعة البحث تقع في النهاية الغربية لساحة قصر الخليفة على محور باب العامة وقصر الحير (شكل 2).
سبق وأن قام مشروع تطوير مدينتي سامراء والمتوكلية الأثريتين بإجراء مجس في المكان الذي يتوقع أن تكون فيه قبة قصر الخليفة (قاعة الاستقبال الكبرى) في شهر حزيران من العام الماضي / 1989 ، حيث ظهرت بقايا جزء مدور وآخر مثمن حوله توحي بأنها أساس لقاعدة القبة أو ما شابه ذلك، ولكن العمل قد توقف في هذا المكان بسبب انشغال المشروع بإكمال صيانة قصر المعشوق في الجانب الغربي لنهر دجلة مقابل باب العامة بغية تهيئته للافتتاح في شهر آب ضمن احتفالات القطر بأعياد النصر والسلام لعام 1989.
ص: 403
ضمن مهام المشروع للموسم الجديد / 1990 القيام بأعمال الصيانة في البركة الدائرية إضافة إلى أعمال التنقيب في بعض النقاط في قصر الخليفة بحثاً عن موقع قبة القاعة الرئيسة وارتباطه بأبنية باب العامة من جهة الغرب، وهكذا استؤنف العمل التنقيبي في الموضع المذكور والذي يقع في محور باب العامة وقصر الحير، إلى الشرق من الباب العامة بمسافة (270م) وإلى الجهة الجنوبية من المدخل الجنوبي للبركة مسافة ( 100م) ، وعلى بعد (80م) عن الممر السري (السرداب) الذي يخترق ساحة قصر الخليفة من الشمال إلى الجنوب.
بدأ العمل التنقيبي بشكل مكثف في بداية شهر نيسان / 1990 في المكان المذكور، وعلى مساحة تقدر ب_ (900م2) تقريباً، حيث تم تنظيف حفرة عميقة مدورة قطرها (25م) حفر منها بالعمق في حدود (4م)، حيث أسفرت تلك الأعمال عن الكشف عن حوض مدور (شكل 3) أو منطقة مدورة قطرها (10/5م)، يحيط بها حائط بعرض (1-1/10م) مبني بالآجر المربع (30×30×7سم) والمونة المكونة من الجص والرماد والنورة، ويبلغ الارتفاع المتبقي من هذا الجدار (80سم) تقريباً، وقد تبين أن معظم آجره قد اقتلع وكذلك الحال بالنسبة إلى داخل الحوض، وهذا واضح من الحفر الكثيرة التي شوهت منظره (لوحة 2)، وهذه حالة شائعة في الأبنية القديمة لمدينة سامراء العباسية فأصبحت الدور والقصور تحت رحمة سراق الآجر تتناولها بالحفر على أجزائها الخشبية وأجرها (1)بغية استخدامها في بناء مساكنهم الخاصة.
يوجد رصيف دائري بين الجزء المدور (الحوض) والمنطقة المثمنة الشكل بعرض 1,5م) ، من الواضح أن أرضية هذا الرصيف قد رصفت بواسطة الألواح المرمرية حيث بقيت أجزاء منها مكونة من المرمر مختلف الأشكال والأحجام (لوحة 3و4) قياساتها X37 731 X سم و 31×17/5×7 سم يبدو أن استخدام تلك الألواح
ص: 404
المرمرية غير المنتظمة كان لضرورة العمل الفني في تبليط هذا الرصيف، ومن قياساتها أيضاً (51× (32×15)×7/5 سم)، هذا وقد غلف الجدار المدور حول الحوض بدوره بواسطة المرمر وبارتفاع 80سم (لوحة 5 ) .
إن المرمر قد استخدم في تغليف جدران الجزء المثمن وكان طول ضلعه (6/5م)، بألواح مرمرية أصغر حجماً قياساتها (32×13×4سم) و (25×20×4سم) (لوحة 6). لاحظنا أن أرضية الحوض الدائرية قد بنيت بالطابوق المربع والنورة والرماد وبسمك (1م) تقريباً على شكل طبقات متراكمة، وهذا النظام استخدم أيضاً في تقوية وتسليح الحوض الدائري الكبير في البركة الدائرية (لوحة 7)، إذ إن لهذه المادة أو المزيج القدرة على تحمل الرطوبة والأملاح (1)، إذ من الملاحظ أن الجدار المدور والرصيف وجدران الجزء المثمن والممشى الذي حول المثمن قد بنيت جميعها بتلك المادة (لوحة 8) ، يبلغ عرض الرصيف الذي يحيط بالجزء المثمن (3م) تقريباً وبسمك (20سم) أي 2 مدماك (ساف) الذي بني من الطابوق الفرشي وأنصاف الطابوق والكسر مع الجص والنورة والرماد، يتراوح الفرق بين مستوى أرضية الرصيف حول الجزء المثمن والتبليط الكائن أمام المرافق البنائية التي تكون بمستوى أرضية الساحة الكبرى للقصر (1٫5م) (لوحة9) ، أي أن هناك احتمال درج ينزل إلى الحوض في مكان ما لم نهتد إليه بسبب التخريب. يبدو أن التخطيط المثمن من الظواهر العمارية المألوفة في سامراء فتجده في القبة الصليبية (2)وحصن القادسية وغرفة في الدار رقم (4) .
إن أرضية هذا الجزء الذي يكون أمام المرافق البنائية على امتداد السور الغربي للقصر قد بلطت بواسطة الطابوق الفرشي الكبير (45×45×5سم) مقارباً لحجم الطابوق المستخدم في تبليط الرصيف الذي يحيط بالحوض في البركة الدائرية الكبيرة.
ص: 405
هوية الأثر:
نحاول في هذا البحث أن نسلط الضوء على ثلاثة عناصر مهمة في معرفة هوية الأثر:
مراجعة الخارطة التي وضعها الأستاذ هرتسفيلد (1)، حيث ثبت نافورة في هذا المكان.
دراسة المواد البنائية التي استخدمت في بناء الأثر شكله العام.
التعرف على الأحواض التي بنيت فوقها القباب.
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، فإن الأستاذ هرتسفليد قد وضع خارطة تفصيلية لمنطقة قصر الخليفة ابتداء من نهر دجلة من جهة الغرب، مروراً بباب العامة والحبة الكبرى للقصر، وصولاً إلى قصر الحير، ثم البناية التي تشرف على حلبة السباق في أقصى الشرق وعلى الشارع الأعظم (شكل 1) ، يمكننا أن نتأكد من وجود نافورتين في النصف الغربي للقصر، والتي نحن بصدد دراستها؛ والأخرى ما تزال مدفونة تحت الأنقاض، إذ لم تجر فيها أعمال التنقيب لحد الآن.
أما النقطة الثانية فهي دراسة مواد البناء المكونة من الطابوق المربع (30×30×7 سم) والمرمر ، والمونة من الجص والرماد والنورة، ومقارنتها بالقناطر والعبارات التي بنيت قديماً على الأنهار مثل النهروان ونهر الرصاص بنفس المادة، ونذكر منها قنطرة الرصاص على نهر القاطول الأعلى، وبناء سد العظيم الذي يعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام، إذ أن مونته تتألف من خرسان مزيجه من الجص والنورة والحصى الناعم والرماد، إذ كون هذا المزيج خرسانة قوية للغاية بين الطابوق وكتل الحجارة المستخدمة في بناء تلك القناطر والسدود من الجدير بالملاحظة ان المادة نفسها قد استخدمت في بناء الحوض الكبير للبركة الدائرية التي اكتشفت حديثاً في
ص: 406
سامراء (قصر الخليفة) (لوحة 7) ، إذ إنها على درجة من المتانة والصلابة يصعب الحفر فيها، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن أرض سامراء في منطقة قصر الخليفة مكونة من طبقة صخرية من النوع المعروف جيولوجياً باسم كونكلو ميريت (cong lomerte) المكونة من حصاة مختلفة ملتحمة مع بعضها (1) على درجة عالية من القوة والصلابة وكأنها خرسانة كونكريتية لحفظ المياه.
أما من حيث الشكل العام للحوض الذي تم الكشف عنه فإنه مكون من حوض دائري يحيط به حائط مدور ورصيف مبلط بالمرمر ، ويلي هذا الرصيف شكل مثمن (شكل 5)، وبعد ذلك ممر حول الجزء المثمن ، أي أنه صمم فعلاً على شكل نافورة أو حوض للماء، ولا تنطبق تلك التفاصيل على أسس أو قاعة قبة قصر الخليفة التي يجب أن تكون على درجة كافية من المتانة حتى تتحمل ثقل البناء الضخم وقبة كبيرة من فوقها .
أما النقطة الثالثة فهي الأحواض التي فوقها القباب.
حاولنا في هذا البحث أن نجد العلاقة بين الأحواض التي فوقها القباب ونقصد بها (الميضاة) في صحن المساجد والجوامع، وقبة قصر الخليفة (قبة قاعة الاستقبال الكبرى) في سامراء، فان هذا المكان لا يمكن أن يكون موقعاً لإقامة قبة كبيرة؛ بسبب ضعف الجدران كما ذكرنا سابقاً، وقد استعملت القباب لتغطية المياضي (2)التي أقيمت وسط صحن المساجد المكشوفة، ويقصد بها حوض ماء لغرض الوضوء، وتكون هذا الحالات في القباب القائمة وسط صحن الجوامع فقط (3).
ص: 407
وبهذا المعنى ذكر مؤلف كتاب (تاريخ ووصف الجامع الطولوني) (1): (في وسط صحن جامع ابن طولون ميضاة مرفوع عليها قبة كان محلها في الأصل على ما ذكره المقريزي بناء أعلاه قبة مشبك جميع جوانبه عشرة أعمدة رخام ويحيط به 16 عموداً من الرخام).
ولكن الملاحظ أن النافورات التي بنيت فوقها القباب كانت شائعة في المساجد والجوامع، يقال بأن نافورة ابن طولون لم تكن مخصصة لغرض الوضوء وانما اتخذت زينة في داخل الصحن فقط.
الاحتمالات: -
هناك احتمالان لماهية هذا البناء الأثري، إما أن يكون:
الاحتمال الأول: موضعاً لقاعدة قبة قصر الخليفة، ففي هذه الحالة يجب البحث عن الأسس التي تكون صلدة ومتينة بما فيه الكفاية كي تتلاءم وتتحمل بناء قبة كبيرة، وتنسجم مع ضخامة وروعة المرافق البنائية التي ما تزال باقية في قصر الخليفة بسامراء، المتمثلة في باب العامة وقصر الحير وجدار السور الكبير وأخيراً البركة الكبيرة التي تعتبر بحق من أروع ما خلفه لنا العباسيون من الآثار البنائية، لروعة هندستها وضخامة أجنحتها، إن تلك الأوصاف لا تنطبق على مكان هذه النافورة إذ لا وجود للأكتاف والدعامات التي يمكن أن تشكل الأساس لقاعدة القبة، لذلك فإن احتمال وجود حوض ماء أو نافورة أسفل قبة القصر في هذا الموضع بالذات أمر غير وارد إطلاقاً.
الاحتمال الثاني: هو أن يكون حوضاً للماء أو نافورة أمام مرافق القصر على محور باب العامة وقصر الحير، ففي هذه الحالة يجب علينا البحث عن المصدر أو القناة التي تغذي هذه النافورة بالمياه وبصورة مستمرة، إذ إن التنقيب لم يكشف لنا عن هذا
ص: 408
المنفذ المائي ربما بسبب التخريب الحاصل في هذا المكان، ، ومع ذلك فنحن نرجح أن يكون نافورة لغرض الزينة وتلطيف الجو في داخل حدائق قصر الخليفة.
ص: 409
fountain of the khalif Al-mu`tasim
In Samara`a
The city of Samarra was founded in the year 221 A.H. during the reign of khalif Al-mu`tasim bin Harun Ar-rashed. who founded a new capital of the Abbasid state. in its archi- tecture, this city passed in two stages: the first stage which comprises the architectural achievements conducted by kha- lif Al-mut`asim. While the Second stage was comprising the additions and expansions conducted by Kalif Al-mutawakkil.
The most important fulfillments of Al-mu`tasim were the foundation of the city also dividing in into quarters and dis- tricts, Divisions of the army dwelled. the Khalif was also interested in isolating the army and the state administrative buildings from the civilians.
The city reflects a high skill of the city planning as to the regulation of the streets, houses, publics utilities, markets, shops, mosques, orchards etc. The length of the city during the reign of Al-mu`tasim was about 19km. Which was com- prising many parallel streets like Al-khaleej street which was parallel to Tigris. And the famous street (Al-sreja).
The most prominent edifice erected in the later str. is the place of khalif Almu`tasim or that known as the house of the commons, and the palace of Al- jawsaq Al- khaqani in which the khalif used to sit on each Monday and Thursday:to give audience to the people.
The excavations in the Fountain were initiated in April 1990 in an area of about 900m2, seeking the dome of the kha- lif palace. on the axial of Bab Al- amma and the present pal- ace of Al-heer.
Digging up started in a deep circular control pit 25m in
ص: 410
diameter and 4m in depth. The excavations revealed a circu- lar water basin with 10.5 m diameter which was flanked by 1.10m thick wall that constructed with square bricks measur- ing 30x30x7 cm with gypsum.
ashes and (Nora) in amanner of deposited layers. This measurement was used in the firming and strengthinning of the big circular basin in the known circularpond. Since this mixture had the ability to resist salts and moisture for aver long times...
الصورة
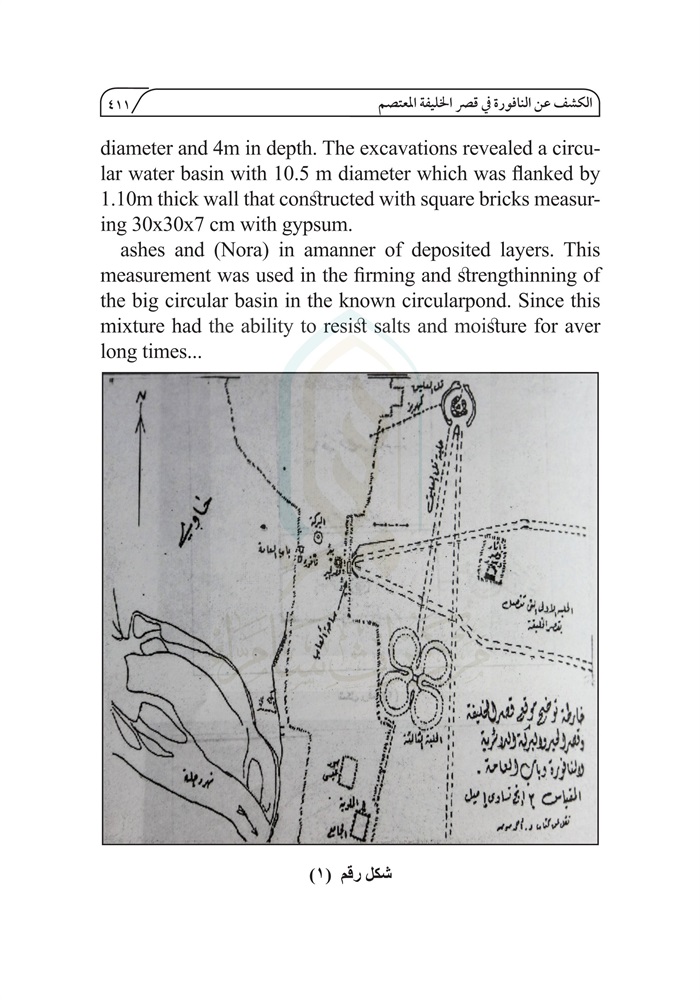
ص: 411
الصورة
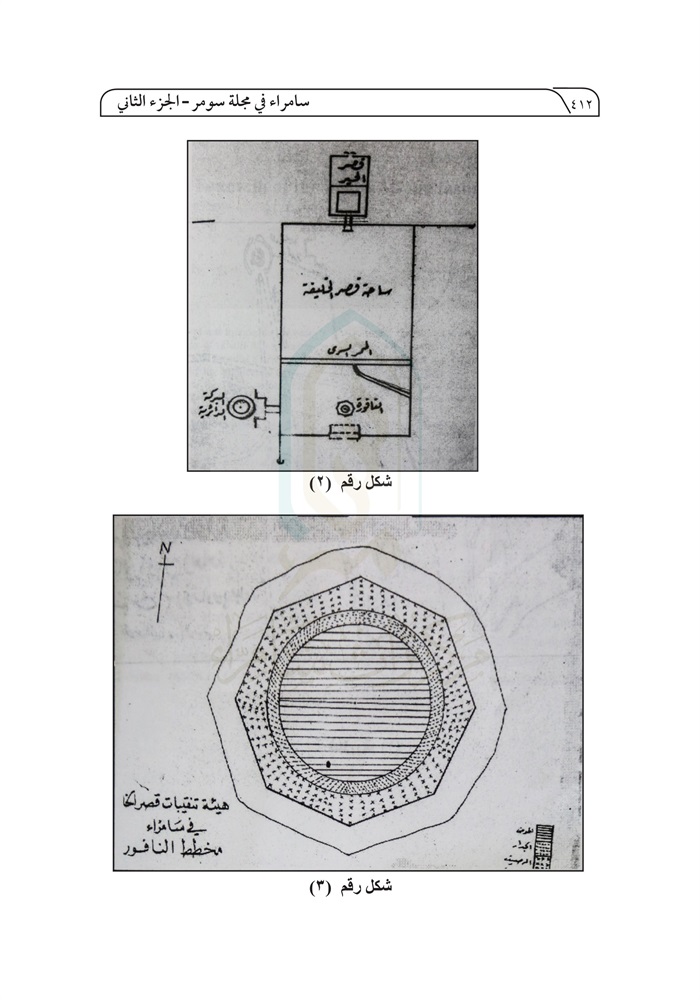
ص: 412
الصورة
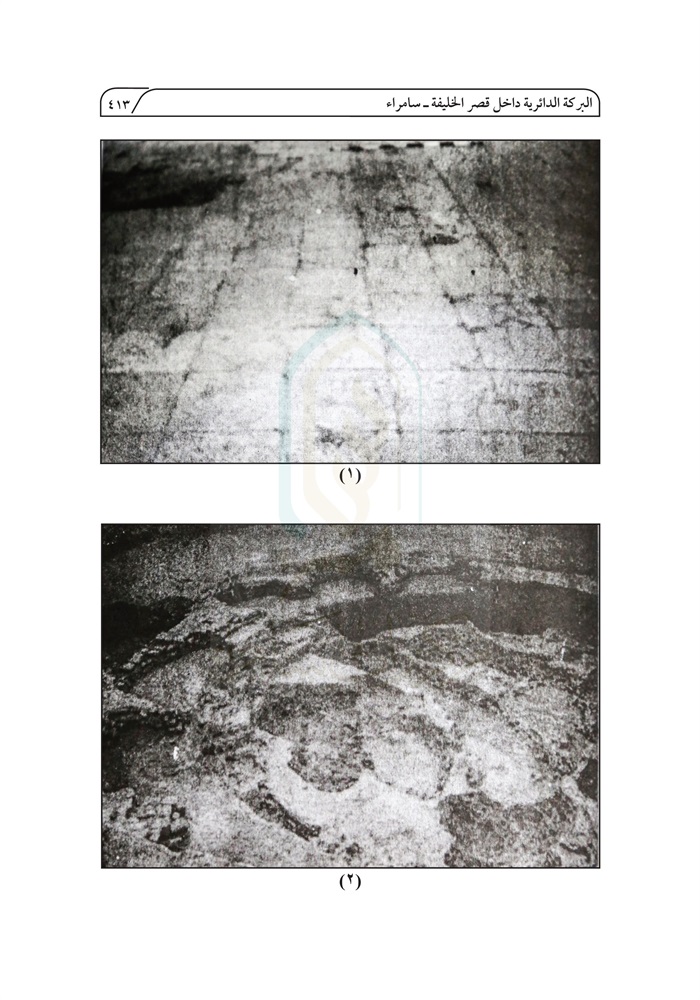
ص: 413
الصورة
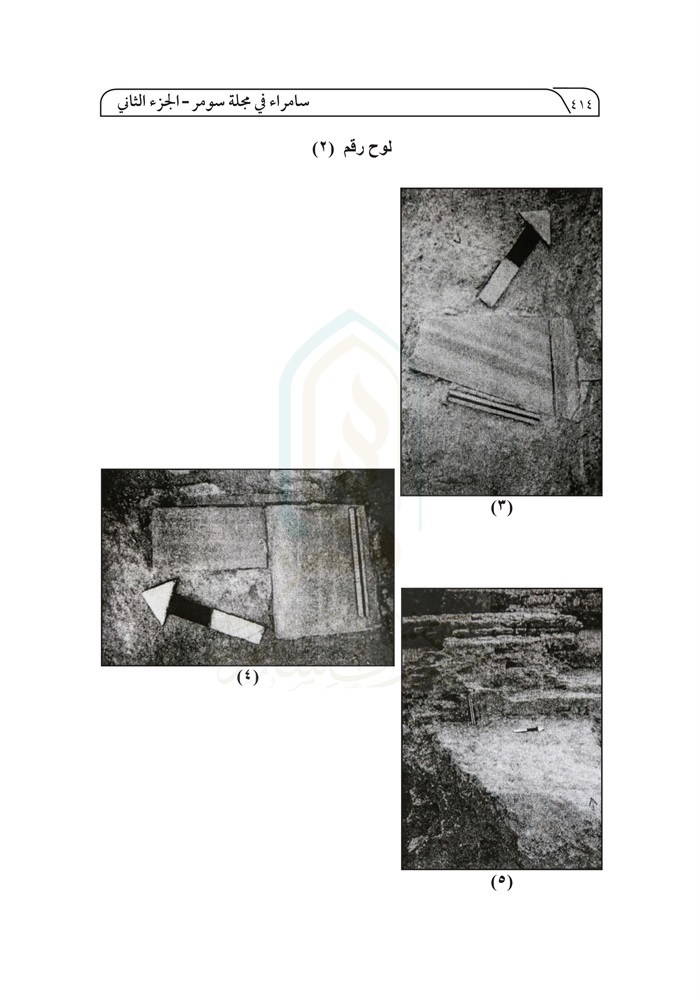
ص: 414
الصورة
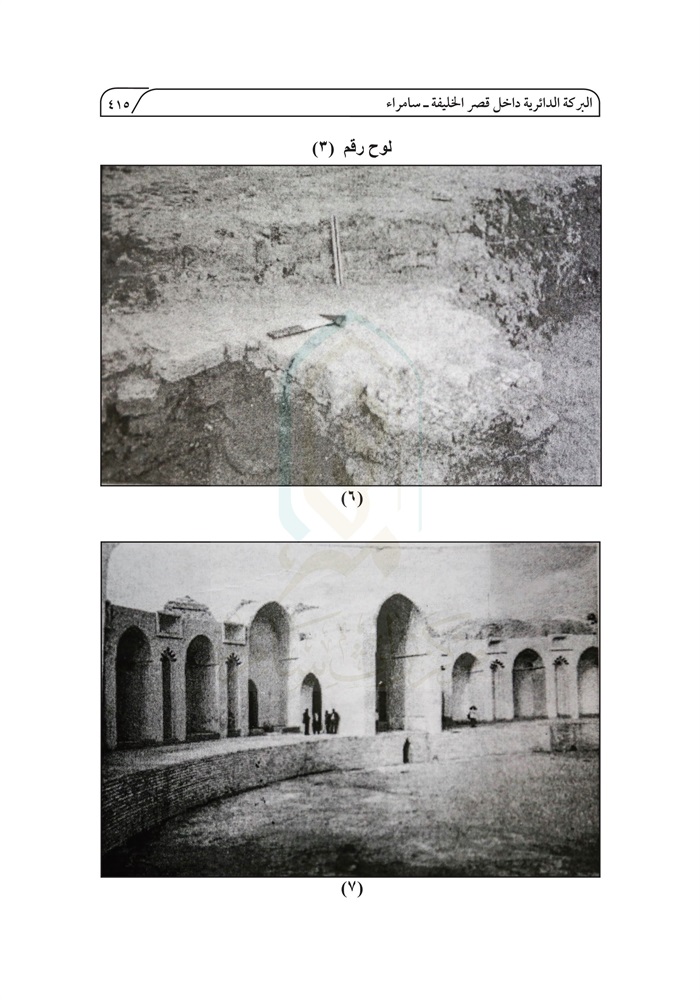
ص: 415
الصورة
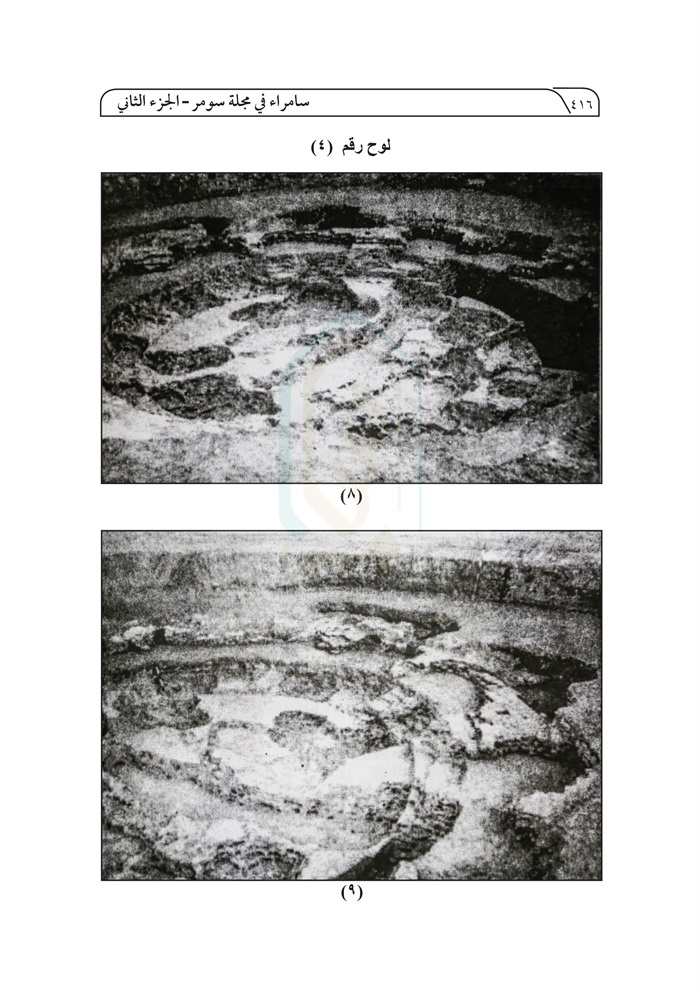
ص: 416
المجلد الواحد والخمسون سنة 2001 - 2002م
(مشروع تطوير مدينتي سامراء والمتوكلية الأثريتين)
حافظ حسين الحياني
وصف عام لحمام البركة بسامراء:
يقع الحمام داخل قصر الخليفة (دار العامة)، وهو بشكل عام بناء غير منتظم (مخطط 2) تبلغ مساحته 760م2 ، وهذه المساحة هي أكبر مساحة يقام عليها حمام مكتشف لحد الآن خاص بالخليفة العباسي وملحق بقصره، أي ليس قائماً بذاته كما كان يحدث قبل الإسلام(1).
يقع الحمام في الزاوية الجنوبية الشرقية من البركة المكتشفة خلال التنقيبات لمشروع تطوير آثار سامراء(2) خلال عام 1988 ، على عمق 13 م من مستوى الأرض الأصلية، ويقسم المبنى إلى أربعة أقسام هي:-
القسم الأول : للابتراد (الجو العادي)، ويحتوي على ثلاث حجر مختلفة المقاسات، وهي (6 ، 7، 8 ) في المخطط.
القسم الثاني : للاغتسال والتدفئة، تحتوي على ثلاث حجر، رقم (9، 10، 11).
القسم الثالث: يحتوي على خزان المياه والإيوان الذي يتقدمه، رقم (12، 13).
ص: 417
القسم الرابع يحتوي على مخزن الوقود والموقد الناري الذي يعلوه حوض المياه الساخن.
ويحتوي الحمام على خمسة مداخل يفتح أحدهما على الممر الدائري باتساع 1،7 م رقم (1) على المخطط، أما المدخل رقم (2) فهو يفتح على أحد القاعات الجانبية للواجهة الجنوبية من البركة بلغ عرضه حوالي 1 متر ، والمدخل رقم (3) يؤدي مباشرة إلى الممر المسرح «ramp» الموجود في الجانب الشرقي من الواجهة الجنوبية وعرضه 1 متر، اما المدخل رقم (4) فهو يتصل بالقاعة الجانبية للواجهة الشرقية من البركة ويبلغ عرضه 1 متر ، والمدخل رقم (5) يتصل مباشرة بالممر المسرح «ramp» الموجود في الجهة الجنوبية للواجهة الشرقية من البركة .
ومن الجدير بالذكر ان جميع المداخل تؤدي إلى داخل مرافق الحمام عدا المدخل رقم (3)، فهو يؤدي إلى مخزن الوقود الموجود في الركن الجنوبي الغربي من الحمام.
ويتكون الحمام من ست حجرات كما هو مبين على المخطط (2 ، 3) مختلفة من حيث المساحة ومن حيث أشكال العقود التي تتوج الحنايا، الغرفة رقم(7) وهي للاستقبال أي للراحة قبل البدء.... بالاستحمام، وتخلو جدرانها من الحنايا، وأرضيتها من الجص المخلوط بالرماد، وقد اندثرت جميع جدرانها، ويرجح بان جدرانها قد زخرفت بالألوان المائية وبالفسيفساء، بدلالة عثورنا على عدد من القطع التي تؤيد وجود هذه الزخرفة في تلك المنطقة (الصورة 5) .
وترتبط المداخل ببعضها وتفتح على الممر الذي يؤدي إلى مخزن الوقود حيث أقيمت فيه مصطبة مرتفعة عن مستوى أرضية الممر المبلطة بالأجر الفرشي قياس 30 × 30 × 3سم . أما الحجرة رقم (8) فقد عثر بداخلها على مصطبة لعلها استخدمت للجلوس، ومرتفعة عن مستوى سطح الأرض بحدود 50 سم، وتلاصق الجدار سم، الشرقي من الحجرة والذي يزينه شريط من الجص بديع، كما إن أرضيتها مبلطة
ص: 418
بالجص أيضاً، ويحتمل أن تكون جدرانها تحمل نفس زخارف الحجرة رقم (7) خاصة، وإن جدرانها اندثرت ولا توجد أدلة تشير إلى وجود حنايا تشبه المحاريب كما ان سمك الجدار البالغ 1 متر لا يسمح بوجود حنايا به، ويتوسط جدرانها مدخل عرضه 35 و 1 م وتفتح على الحجرة رقم (9).
أما القسم الثاني الخاص بالاغتسال والإحماء فهو يتكون من ثلاث حجرات: الحجرة رقم (9) تزين جدرانها حنايا تشبه المحاريب مختلفة القياسات، تتوجها عقود مختلفة تتوج الحنايا الصغيرة، وهي عقود من النوع المدبب ذي الأربعة مراكز (الصورة 6 ) ، وتتميز هذه الحنايا بأنها حنايا مزدوجة، أما الحناية الكبيرة فيتوجها عقد مفصص، وهذا ما يزيد من قيمتها الفنية.
تعتبر حجرة رقم (9) حلقة وصل بين الحجرتين رقم (10) ورقم (11)، كما أنها تفتح على الإيوان الذي يتقدم خزان المياه بواسطة مدخل عرضه 2،20 يعلوه عقد مدبب كما وان الحجرة رقم (9) تتصل بالحجرة رقم (10) عن طريق مدخل عرضه 1/35 م بينما الحجرة رقم (10) تحتوي على أربع حجرات صغيرة موزعة في زوايا الحجرة الأربع، ومما تجدر الإشارة إليه أن أرضية الحجرات الأربع الصغيرة تختلف عن أرضية باقي الحجرات (الصورة 7)، حيث نجد أن الأرضية محمولة على عدد من الصفوف المبنية من الآجر، والتي هي بمثابة دعامات يعلوها عقد، ويعلو العقد طابوق قياس الواحدة 30×30 × 3سم، ويعلو هذا الطابوق طبقة جصية مخلوطة بالرماد، يلاحظ أيضاً أن استخدام العقود في التسقيف يعمل على تحمل البناء ويزيد من متانته، وقد بلغ عدد الدعامات 152 دعامة سمك كل منها 30 سم وارتفاعها 40 سم، وتبلغ المسافة من الأرضية والتسقيف 1/20م علماً بأن الفجوات الناتجة من صفوف الآجر سالفة الذكر تتخللها الحرارة الاتية من الموقد الناري عن طريق فتحة تربط بين الموقد والفجوات، وتعمل على إحماء الأرضية، وتخلو جدران هذه الحجرة من الزخارف، أما أرضية الحجر الأربع الصغيرة فهي
ص: 419
صماء، ويحتمل أن تكون قد استخدمت للتدليك والاغتسال بالماء العادي، فتسيل المياه من أرضيتها إلى باقي أرضية الحجرة رقم (10) ، وبذلك تصبح دافئة، حيث تتبخر المياه.
وعن طريق مدخل متسع يتوسط الجدار الجنوبي للحجرة رقم (9) تصل إلى الحجرة رقم (11) وتزين جدرانها حنايا تشبه المحاريب عددها 13 حنية تتوجها عقود مفصصة (صورة 9).
وقد تم العثور على مثل هذه العقود تتوج نوافذ المسجد الجامع في سامراء، وفي واجهة قصر المعشوق مما يؤكد لنا أقدم مثل لهذا النوع من العقود الإسلامية وجد بسامراء. أما ما هو موجود في باب الرقة فهو يرجع إلى عام 264 ه_ - 878 م3 .
عموماً فما هو موجود في البركة يختلف عما هو موجود في قصر المعشوق (صورة 10 ، 11)، حيث نجد في حمام البركة ان العقد المدبب ذا الأربعة مراكز في تتويج حنية واحدة ( صورة 7 و 9)، كما يعلو العقد المفصص مشكاة عرضية ذات شكل نصف بيضوي، تعلوها واحدة أخرى رأسية تحصران داخل إطار زخرفي.
كما نجد أن أرضية الحجرة المحمولة على عدد من الصفوف الآجرية، والتي تشبه الدعامات البالغ عددها 144 دعامة، تأخذ المياه الساخنة من حوض المياه الذي يعلو الموقد الناري المجاور لها من جهة الغرب، ويتخلل جدارها ستة ملاقف هوائية لخروج الدخان، ويحتمل انها تعمل على تسخين جو الحجرة أيضاً.
وفي الركن الجنوبي الشرقي من الحمام نجد مخزناً للمياه (المخطط 3) ، كما يلاحظ تدرج هندسي يشبه جهاز قياس ارتفاع المياه في الوقت الحاضر في جداره الغربي، يبدأ من الأعلى باتجاه الشمال حتى يصل إلى الأرضية باتجاه الجنوب، لمعرفة المستوى المتبقي من المياه.
ويتقدم المخزن باتجاه الشمال إيوان ربما كان لإقامة المشرف على توفير المياه
ص: 420
للحمام، ويصل بين الإيوان والخزان فتحة تبدأ من ارتفاع 2 م عن مستوى الأرض تبلغ مساحتها 1 متر ، وجدير بالذكر انه تم الكشف عن طريق تزويد هذا الخزان بالماء بواسطة بئر مجاور لهذا الخزان من الناحية الجنوبية في الجزء العلوي من البركة.
إن هذا الحمام ملحق بأحدى الوحدات السكنية وليس قائماً بذاته، ويزيد على ذلك أيضاً انه حمام خاص بالخليفة وليس من حمامات العامة، لذلك اهتم الفنان والمعمار في هندسة بنائه وزخرفة جدرانه، حيث نرى الجدران تزينها حنايا تشبه المحاريب تتوج عقوداً متنوعة، وتقوم فوق هذه الحنايا مشكاوات مستعرضة ورأسية، واستخدامه للرسوم النباتية بالألوان المائية كل هذا يتماشى مع روح الفنان المسلم الذي بعد كل البعد عن الرسوم الآدمية والحيوانية.
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى الإبداع الهندسي في بناء الحمام، والذي يتضح في عملية تغذيته بالمياه وتصريفها، ومخزن الوقود في الركن الغربي من الحمام يقوم على مساحة 5م × 3م ، يتقدمه الموقد الناري الذي يعلوه حوض المياه الساخنة.
أما الحجرة رقم (6) ، والتي أشرنا إليها في بداية الوصف، والتي يسودها بعض الغموض للأسباب التالية:-
1 - اختلاف أرضيتها، حيث إنها مبلطة بالآجر الفرشي قياس 30×30×3سم.
2 - يتوسطها بالوعة تؤدي إلى ساقية المياه، وبدورها إلى الكهريز الجنوبي.
3- يحيط بهذه البالوعة أسس جدران خشبية تم العثور على بقاياها (للتغليف).
4 - العثور على فجوات متسلسلة في جدار الحجرة الشرقي.
ه - اندثار الجدران واتصالها بالمداخل مباشرة.
6- وجود مقصورة في الجهة الشرقية الملامسة للسنّ الصخري.
لهذه الأسباب قامت هيئة المشروع بدراسة هذا الغموض، وتوصلت إلى الآتي:
ص: 421
يرجح أنها سقفت بسقف من الخيش بشكل جملون، خاصة وأن نظام التخييش كان مألوفاً في تلك الفترة الزمنية (1).
فضلاً عن وجود الأسس الخشبية التي تحيط بالبالوعة، والتي ترتفع إلى الأعلى حيث تتقاطع مع العوارض الخشبية من كل الجهات لتشكل السقف الجملوني المخيّش، والذي يرجح أن المياه المعطرة كانت تصب عليه، والتي تنتج عنها رائحة طيبة وهو رطب؛ ليدخل البهجة والسرور على نفس القادم لتلك الحجرة.
ويؤيد هذا الترجيح وجود فتحة البالوعة التي تعمل على تصريف المياه، كذلك وجود المقصورات التي سبق ذكرها، والتي كانت تستخدم كموضع تصب منه المياه.
طريقة التسقيف
لم يبق من السقف الذي كان يغطي الحمام سوى بعض الأجزاء المتبقية من أعلى بعض الجدران، والتي يمكن أن نستنتج منها أن الحمام كانت تعلوه قبة، وهذا ما جرت العادة عليه، ولكن هذا نموذج متطور حيث استخدمت المقرنصات لتحويل الشكل الرباعي إلى مثمن لإقامة القبة، وفي نفس الوقت له وظيفة جمالية بديعة كما يظهر في (الصورة 9) حيث تظهر بقايا المقرنصات عند تلاقي الجدار الجنوبي بالجدار الشرقي من الحجرة الحارة، وفي نفس الصورة نموذج من المقرنصات والعقد المفصص في الركن الجنوبي لحمام البركة بسامراء.
تغذية حمام البركة بالمياه
يتم تغذية الحمام بالمياه عن طريق خزان المياه الواقع في الركن الجنوبي الشرقي من الحمام، وجدير بالذكر انه يوجد تدرج هندسي أسفل الجدار الغربي منه، يبدأ من أعلى الجهة الشمالية وينتهي أسفل الجهة الجنوبية من الجدار، ولعله مكان وقوف
ص: 422
السقاء القائم على جلب المياه من مخزن المياه إلى باقي مرافق الحمام.
ويربط الحمام بالإيوان باب عريض يفتح على الحجرة رقم (10) كما يتضح ذلك في (مخطط 2)، ويعلو هذا الباب عقد مدبب، كما توجد فتحة مساحتها 1م في الجدار الفاصل بين الإيوان ومخزن المياه، يبدأ من ارتفاع 1،50 م من مستوى أرضية الإيوان، ولعل هذه الفتحة تساعد السقاء على جذب المياه من المخزن، أما كيفية تغذية مخزن المياه بالماء فمن المحتمل أن تكون من الأعلى، وهذا الجزء من المخزن تهدم. وجدير بالذكر ان وجود سلّم في الجهة الشرقية والغربية من الجدار الجنوبي للمخزن يهبط إلى مستوى التسقيف يساعد على عملية ملئ الخزان بالماء من البئر التي
تتصل بالكهريز.
تصريف مياه حمام البركة
يتم تصريف مياه حمام البركة عن طريق كهريز المياه الفرعي الذي يبدأ من الركن الجنوبي الغربي للحجرة رقم (9) ويخترق الجدار الفاصل بين الحجرة رقم (10) ومخزن الوقود، ويتجه إلى الغرب حتى يصل إلى الكهريز الرئيس الذي يعمل على تصريف مياه البركة إلى نهر دجلة. وجدير بالذكر ان المعمار راعى عملية تجميع المياه من جميع الحجر في الركن الجنوبي الغربي من الحجرة رقم (9) ، حيث جعل أنابيب فخارية تخترق جدران الحجر بمستوى الأرضية، كما جعل الأرضيات مسرحة باتجاه هذا الركن من الحمام.
و بعد دراسة الحمامات السابقة لحمام البركة بسامراء من خلال المصادر التي سبق ذكرها (1)، والوصف التحليلي لحمام البركة المكتشف أثناء التنقيب، تبين لنا وجود شبه بين حمام البركة والحمامات التي سبقته في الظهور، كما توجد أوجه اختلاف بينهما (2) .
ص: 423
أوجه التشابه
يتفق بناء جميع الحمامات في تدرج الحرارة، وذلك يتم من خلال تقسيم الحمام إلى حجرة مترابطة، فنجد بصورة عامة الحمامات تنقسم الى : -
1 - قسم الابتراد.
2 - قسم الاغتسال والتدفئة.
3- قسم لتسخين المياه وخزنها وتجميع الوقود وتفريغ المحروقة (الرماد)، مع ملاحظة أن القسم الثاني ينقسم إلى عدد من الحجرات:
الحجرة الأولى باردة، والثانية دافئة، وهي حلقة وصل بين الحجرة الأولى والثالثة الساخنة (الحارة) حتى لا يفاجأ المستحم بارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها، وهذا يتماشى مع المتطلبات الصحية .
أوجه الاختلاف
تجت بسبب التطورات التي طرأت على حمام البركة.
1 - الموقع : وقوع حمام البركة في الركن الجنوبي الشرقي من البركة وهذه الحال تحتاج إلى دراسة من قبل المسؤولين عن أحوال الطقس في بلاد الرافدين، ولعل هذا المكان يتفق مع اتجاه هبوب الرياح التي تعمل على إبعاد الدخان خارج الموقع، إضافة إلى وجوده في باطن الأرض بعمق وهذه ظاهرة فريدة امتاز بها دون نظائره فجعله فريداً من نوعه في العمارة الإسلامية.
2- المساحة التي يقوم عليها حمام البركة نجد أن المساحة التي يقوم عليها حمام البركة وملحقاته تساوي ثمانية أمثال أحد الحمامات السابقة له، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنه مقام في باطن الأرض 13م عن مستوى سطح دار العامة، واستخدم الآجر والجص في عملية البناء ومادة النورة والرماد والزفت ولا نبالغ
ص: 424
حينما نذكر أن مساحة حمام البركة يقام عليها اثر عماري يحوي جميع العناصر العمارية الخاصة للقصر، أو البيت، وهذا دليل على مدى التطور العماري الهندسي لتلك الفترة الزمنية ومدى ازدهار الحالة الاقتصادية.
المصادر
1 - مجلة سومر ج 1، ج 2، مج 38، سنة 1982 .
2- تنقيبات سامراء، ج 1، 1940 .
3- الشافعي فريد العمارة العربية في مصر الإسلامية (عصر الولاة ) ( الهيئة المصرية العامة للكتاب) 1970 ، ص 107.
4 - عن الفنون الاوربية نشرت في مجلة سومر ج 1 ، ج2، سنة 1967.
5 - مصطفى فريال البيت العراقي في العصور الإسلامية، طبعة بغداد 1983م.
6 - صادق زينب : «الحمام العربي الإسلامي» سومر مج 38، 1982، ص 141 .
ص: 425
الصورة
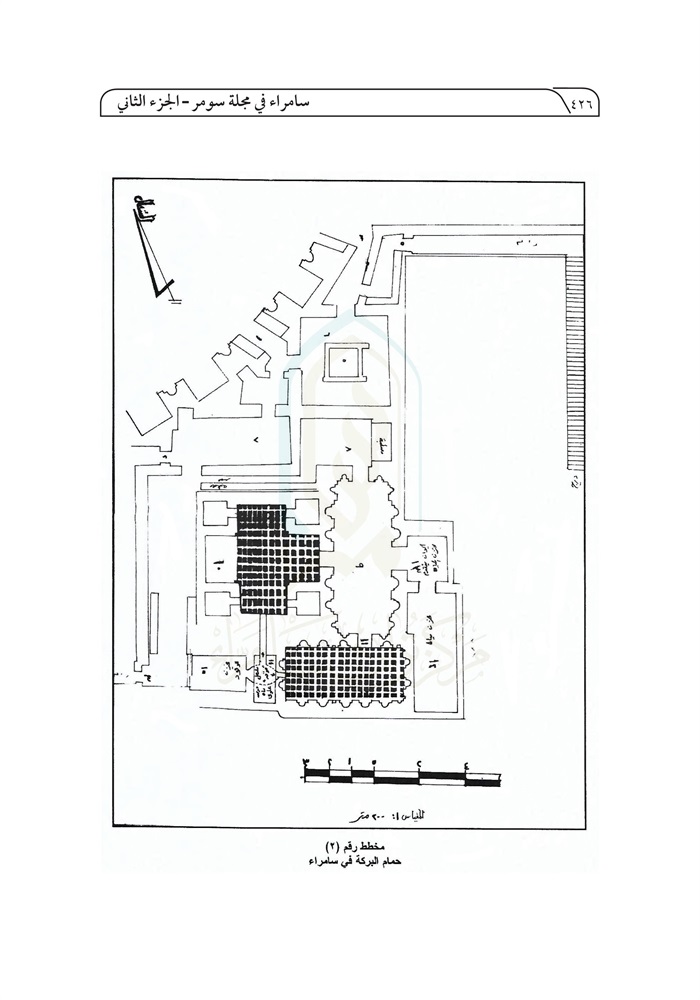
ص: 426
الصورة
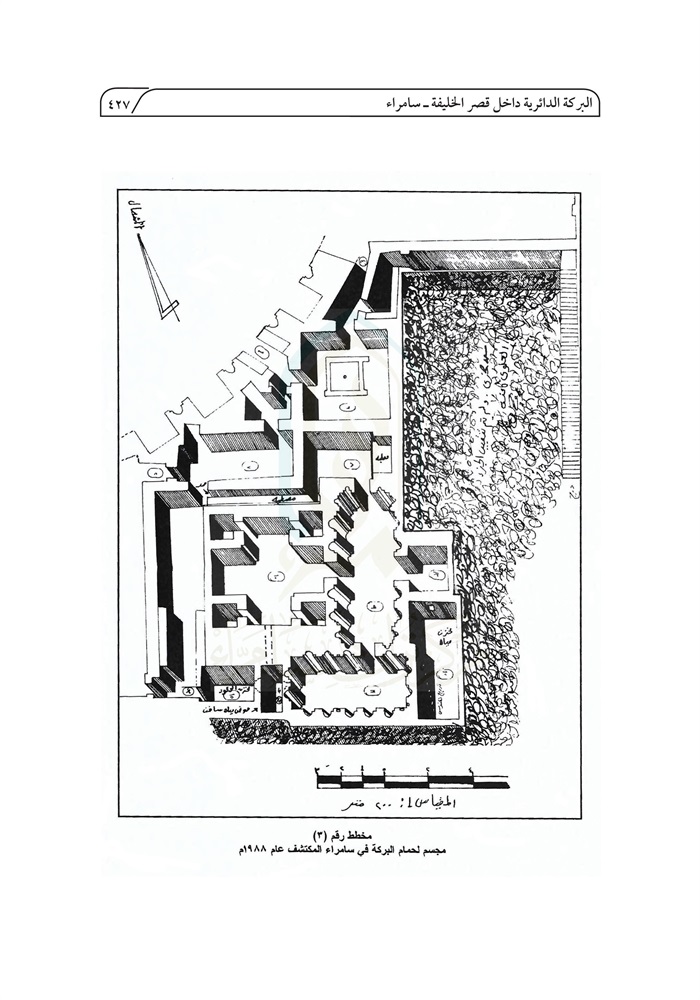
ص: 427
الصورة
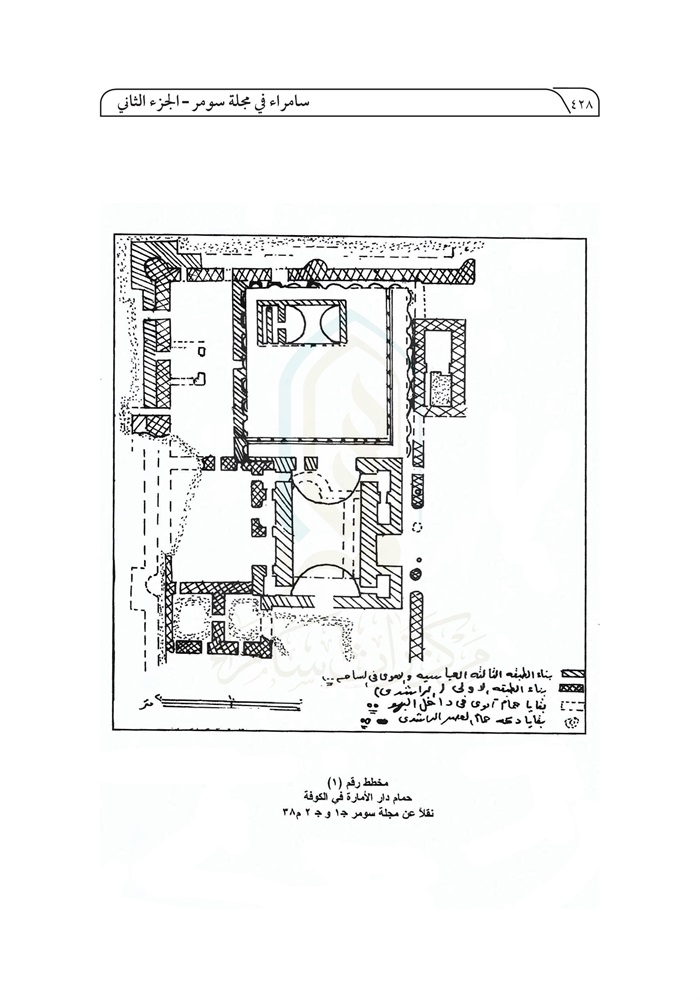
ص: 428
الصورة
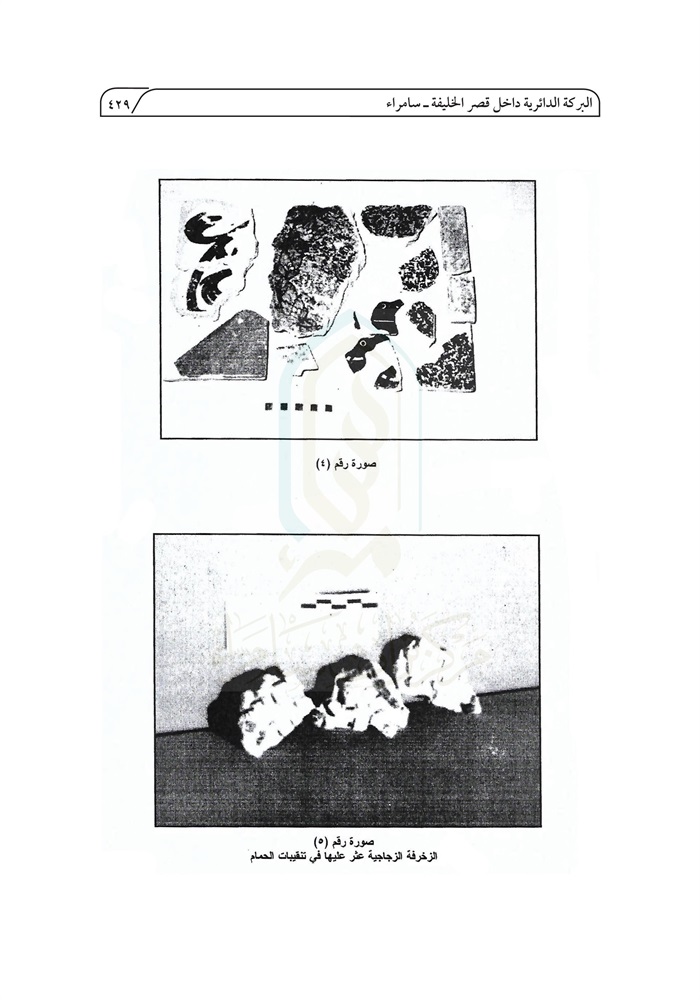
ص: 429
الصورة
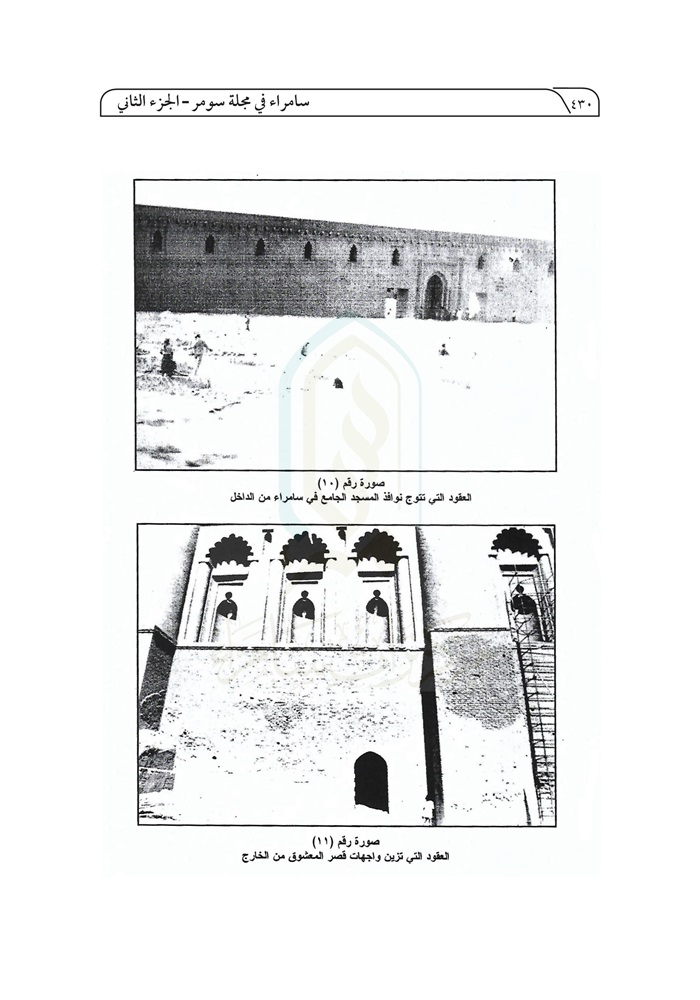
ص: 430
المجلد الحادي والخمسون سنة 2001 - 2002م
(مشروع تطوير مدينتي سامراء والمتوكلية الأثريتين)
صباح محمود القاضي
في عام 245 ه_ / 859م بدأ الخليفة العباسي المتوكل على الله ببناء مدينة جديدة على بعد عشرة كيلو مترات إلى الشمال من مدينة (سر من رأى)، واسمها (المتوكلية أو الجعفرية) (1).
ويمثل الشارع الأعظم فيها الشريان الرئيس للمدينة الجديدة، الذي يبلغ طوله زهاء عشرة كيلومترات ابتداء من شمال سور أشناس وانتهاء بباب البستان وقصور الخليفة المتوكل، ويبلغ عرض الشارع الأعظم أكثر من 100، م. وعلى جانبيه قناتان يجري فيهما الماء (2).
صممت مدينة المتوكلية على أن يخصص القسم الجنوبي فيها لسكنى العامة (دور عرباني)، وإلى الشمال منها كانت قطائع قواد الجيش، وكان لكل قائد قصر يطل على الشارع الأعظم وعلى الشوارع عن يمينه ويساره (الشكل 1)، وإلى الشمال من هذه القطائع على الجانب الغربي من الشارع الأعظم يقع جامع أبي دلف (3)، و تنتهي مدينة المتوكلية شمال الجامع، وينتهي معها الشارع الأعظم عند السور الذي يحد المدينة من الشمال، أما دار الخلافة وقصور الخليفة فتقع إلى الشمال من السور الشمالي في منطقة معزولة، يحدها نهر القاطول من الشمال والشرق، ونهر دجلة من الغرب
ص: 431
والسور من الجنوب، وكان للسور ثلاثة أبواب عظيمة يدخلها الفارس برمحه(1).
وتبرهن بقايا مدينة المتوكلية على أن تخطيطها قد خضع لنظم هندسية دقيقة تتمثل فيها براعة التخطيط والتنسيق، وقد تم ذلك قبل الشروع بإنشائها (2) على نحو ما اتبع في مدينة سامراء وما هو متبع اليوم في إنشاء المدن الحديثة، وتؤكد ذلك الصور الجوية التي التقطت لكثير من أجزائها (الشكل 2)، والتي يظهر فيها مدى ما وصل إليه فن التخطيط العربي الإسلامي من تقدم ورقي من خلال انتظام شوارعها، واستقامة وتوازن خطوطها، فهي تتقاطع مع بعضها وتقوم بينها المباني المختلفة من قصور ومنازل وأبنية عامة وغيرها (3).
وتعد مدينة المتوكلية ذات أهمية كبيرة من الناحية الأثرية؛ إذ إن آثارها ومبانيها ممكن أن تؤرخ بصورة دقيقة، فهي لا تزيد عن عامين، من 245 - 247 ه_ (859 - 861 م) ، كما إن أغلب أبنيتها قد عملت من كتل الطين واللبن فاحتفظت بتخطيطها دون أن تمتد إليها أيدي العابثين، فضلاً عن أن ارتفاع أرضها وتكوينها الجيولوجي من حصى وأحجار متكلّسة حفظها من خطر الفيضان وتأثير الرطوبة.
وضمن الحملة التنقيبية الأولى لمشروع الإحياء الأثري لمدينتي سامراء والمتوكلية في عام 1981 قامت هيئة المشروع بالتنقيب في أحد القصور المطلة على الشارع الأعظم في مدينة المتوكلية، أطلق عليها الدار رقم (3).
ص: 432
الدار رقم (3) الشارع الأعظم (1)
تقع هذه الدار على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات جنوب جامع (أبي دلف)، أي في الجهة الغربية من الشارع الأعظم، وفي الجهة المقابلة للدارين (1، 2) (2) الواقعتين في الجهة الشرقية من الشارع نفسه، ويبلغ طولها 212م وعرضها 106،80م، وهي محاطة بسور مبني بكتل الطين (الطوف) التي يتراوح ارتفاعها بين 50 - 60سم، ويبلغ سمك السور 1،65م ، وهو مدعم من الخارج بخمسين برجاً، أربعة منها في أركانه وهي على شكل ثلاثة أرباع الدائرة أما باقي الأبراج فهي نصف دائرية عدا الأبراج الأربعة التي تدعم مدخلي الدار (الشكل 3)، وتقوم هذه الأبراج على قواعد مستطيلة، أبعادها في الأبراج الركنية 3/5 × 3 م ، وارتفاعها عن سطح الأرض حوالي 50سم، أما أبعادها في الأبراج الأخرى فهي 3 × 1/80 م، وارتفاعها 50 سم، وما تبقى من ارتفاع السور من جهته الشرقية المطلة على الشارع الأعظم 3 م ومن جهته الجنوبية 2/10 م ، كما تدعم هذا السور من الداخل دعامات مستطيلة الشكل أبعادها 1/50م × 80سم ، يتوسط كلاً منها برجان خارجيان، وقد أقيم هذا السور على مصطبة اصطناعية من اللبن تبرز من الخارج بمقدار 30 سم، وكما أشرنا سابقاً إنّ للسور مدخلين، الرئيس يتوسط الواجهة الشرقية المطلة على الشارع الأعظم وهو من المداخل المزورة تبلغ اتساع فتحته الخارجية 3/60م، يحف بها برجان مستطيلا
ص: 433
الشكل لم يبق منهما سوى اسمهما وربما كانا مبنيين من الآجر الذي اقتلعه الأهالي. ويؤدي هذا المدخل إلى مجاز مستطيل طوله 15،50 م، وعرضه 6،10 م، وعلى جانبيه الشمالي والغربي دكتان من اللبن مكسوتان بطبقة من الجص وجدت عليها بقايا مسندين نصف دائريين، ويبلغ طول الدكة الغربية 10،90 م، وعرضها 80 سم، و ارتفاعها 70 سم، أما الدكة الشمالية فيبلغ طولها 6،10م وعرضها 4،60 م وارتفاعها 70 سم، ويتم الارتقاء إلى هاتين الدكتين عن طريق سلم يتكون من درجتين يقع في منطقة التقاء الدكتين، ومن هذا المجاز ومن خلال مدخل ثانٍ له اتساعه 3،50م نصل إلى الفناء الرئيس الذي يشرف على الأقسام الأمامية للدار.
ويمكن تقسيم الدار إلى ثلاثة قطاعات طولية، فالقطاع الشمالي احتوى على مرابط للخيل وبيوت للطيور وعدد من الوحدات السكنية، والقطاع الأوسط فيه القسم الرئيس للدار بينما احتوى القطاع الجنوبي على عدد من الوحدات السكنية، منها القسم الخاص بالضيوف والحمام والمصلّى ومرافق أخرى.
وفي القطاع الجنوبي تم الكشف عن قسمه الشرقي الواقع جنوب الفناء الرئيس والمتكون من ثلاث وحدات بنائية، تواجه الوحدة الأولى باب المدخل الرئيس المؤدي إلى الفناء، وتلاصق السور الشرقي، ويفصل بينهما وبين الوحدة البنائية الثانية مجاز طويل؛ وتضم الوحدة البنائية الأولى عدداً من الحجرات ومصلى مربع الشكل تقريباً طول ضلعه من الشرق إلى الغرب 7/20م ومن الشمال إلى الجنوب 7 م (الشكل 4)، ويمكن الدخول إليه بواسطة مدخلين من الفناء الرئيس ويبلغ اتساع فتحت كل منهما 1/20م، وفي منتصف الضلع الجنوبية للمصلى عثر على محراب مجوف ذي شكل نصف دائري يبلغ اتساع فتحته 1/10م ، وعمقها 80 سم ، ويكتنف كلاً من جانبيه عمودان مندمجان من الجص ، وكذلك أرضية المصلى المغطاة بطبقة من الجص أيضاً (الشكل 5).
والى الغرب والجنوب من المصلى تقع عدد من الحجرات المبنية باللبن والجص،
ص: 434
وفي غرب المصلى وجدت قاعة أرضيتها منخفضة عن أرضية الفناء الرئيس والمصلى بمقدار 40سم، وفي الزاوية الغربية منها يوجد حمام مساحته 1،75 × 1،5 م طليت أرضيته بالقار، وفي الضلع الشمالية من الحمام مدخل يؤدي إلى دورة مياه مساحتها 2/5×1/5م. ويتقدم هذه القاعة رواق 8× 2،15 م ، وفي جهتها الجنوبية يفتح عليها بمدخلين، ويكتنف المدخل الغربي أربعة أعمدة جصية من كل جانب، تقوم على قاعة مربعة 60 × 60 سم وارتفاعها 16، سم ويبلغ الارتفاع المتبقي من كل عمود 95 سم وقطره 4 سم، والى الجنوب من الرواق إيوان مساحته 4،25 × 3،38 م على كل جانب من فتحتيه أربعة أعمدة جصية شبيهة بالأعمدة المارة الذكر، وبذلك يبلغ عدد الأعمدة الجصية في هذه الوحدة البنائية ستة عشر عموداً (الشكل 6).
تقع الوحدة البنائية الثانية في هذا القطاع إلى الغرب من الأولى، ويفصل بينهما مجاز طويل من خلاله يتم الدخول إلى مرافق هذه الوحدة البنائية التي تتكون من مجموعة من الحجرات من أهمها تلك التي تكون الحمام الرئيس لهذه الدار (الشكل 7)، ويتم الدخول إليه عن طريق مدخل اتساع فتحته متر واحد يؤدي إلى الحجرة رقم (5) التي يبلغ طولها 5،50 م ، وعرضها 2،75 م ، وقد وجدت أرضيتها مرصوفة ، بالآجر المربع القياس 50 ×50 × 5سم، ولها دكتان الأولى تلاصق الجدار الشمالي بطوله 2،75 م وعرض 1،50 ويبلغ ارتفاعها 80سم، أما الدكة الثانية فهي تلاصق الجدار الشرقي جنوب المدخل بطول 3،40م وعرض 80 سم وارتفاع 80 سم، ومن هذه الحجرة يتم الدخول إلى الحجرة رقم 6 عبر مدخل مرتفع يتم الارتقاء إليه بسلم من درجتين، وهي مبلطة بالآجر المربع القياس 50 × 50 × 5سم، ومن الحجرة رقم 5 يمكن الدخول أيضاً إلى الحجرة رقم 7 ، إذ تكون وسطا بين الحجرتين رقم 5 و 8 ، ويبلغ طولها 2،45م وعرضها 2/35 م ، وفي هذه الحجرة حفرة مطلية بالقار يتجمع فيها الماء بعد الاستحمام لينصرف من خلال قناة تسير عبر الحجرة رقم 5 إلى خارج الحمام شرقاً لتصب في بالوعة معدة لهذا الغرض، ومن الحجرة رقم 7 يتم
ص: 435
الدخول إلى الحجرة رقم 8 ، ويقع موقد الحمام أسفل أرضيتها، ويتم إشعاله من فناء هذه الوحدة بعد النزول إليه بواسطة سلم من درجتين.
أما الوحدة البنائية الثالثة في هذا القطاع (الشكل 8) فيتم الدخول إليها عبر مدخل مزور ( منكسر) نصل إليه عبر الحجرة رقم 3، الملاصقة للوحدة البنائية الثانية يؤدي إلى الفناء الوسطي لهذه الوحدة البنائية، ويبلغ طوله 5، 15م وعرضه 12،80م، ويحيط بجوانبه الأربعة ممر عرضه (3/3 مبلط بالآجر قیاس 32×32×3 م، وينخفض الجزء الوسطي من الفناء حوالي 20 سم ، ويحتمل انه كان حديقة صغيرة (الشكل 9).
وزينت واجهة الفناء الشمالية بالأعمدة الجصية المندمجة، وجدت مفردة في ركنيها ومزدوجة بين الركنين، ويبلغ قطر الأعمدة المفردة 35 سم، أما الأعمدة المزدوجة فقطرها 25 سم ، وعلى امتداد الواجهة الجنوبية للقسم الشمالي من هذه الوحدة البنائية رواق 11،70 × 3م يقع في جهته الشرقية سلم من ست درجات يصل إلى سطح هذا القسم.
وهناك مدخل جانبي في الضلع الشرقية لهذا الرواق عدا مدخله الرئيس المطل على الفناء المزدان بأعمدة ثلاثية ويقابله مدخل آخر وعلى محور مستقيم يؤدي إلى القاعة الرئيسة لهذا القسم، وهي مربعة الشكل طول ضلعها 4/60 م، وتفتح من جهتها الشمالية على فناء داخلي مستطيل الشكل 5/50 × 6/60م زينت أضلاعه الأربع بأعمدة جصية ثلاثية، وعلى كل من جانبيه الشرقي والغربي رواق، وتقع إلى الشمال من الرواق الشرقي حجرة استعملت حماماً عثر فيها على بالوعة ودورة مياه ودكة موازية للجدار الغربي عرضها 67سم وارتفاعها وارتفاعها 20سم، كما وجدت دكة أخرى في ضلعها الجنوبية، كسيت أرضية الحمام بطبقة من الجص وطليت بالقار، وبلطت القاعة والفناء بالآجر المربع قياس 32×32×3سم.
أما الجزء الجنوبي من الفناء الوسطي لهذه الوحدة فيتكون من جزئين احتوى
ص: 436
كل منها على فناء صغير وثلاث حجرات وزينت واجهته المطلة على الفناء الوسطي بالأعمدة الجصية، وهي على غرار ما موجود في الواجهة الشمالية من هذا الفناء.
و في القطاع الشمالي تم الكشف عن ست وحدات بنائية، فمن خلال مدخلين في الفناء الرئيس يمكن الوصول إلى وحدتين الأولى والثانية (الشكل 10) ، ويتكون كل من هذين المدخلين من مجاز يؤدي إلى الفناء الداخلي لكل من الوحدتين المذكورتين، ويلاحظ أن الوحدة الأولى الشرقية أكبر هذه الوحدات مساحة، أبعادها 30×19م، ويشغل فناؤها مساحة مستطيلة الشكل أيضاً ابعادها 14×17،60 ويطل عليه عدد من الحجرات في أضلاعه الشمالية والجنوبية والشرقية، ففي الجهة الشرقية قاعة كبيرة مستطيلة الشكل مساحتها 14 × 8 م، ويرجح أنها قد استخدمت اصطبلاً للجياد ، على جانبي مدخلها دكتان طول كل منهما 6،50م وعرضه 90 سم وارتفاعه 70سم، وفي ضلعها الشرقية معلف ارتفاعه 1،40 م وعرضه 50 سم وعمقه 30 سم، تقطعه دعامة تقطعه دعامة من دعامات السور الداخلية، كما تم العثور على قواعد طولها 1،70 م وعرضها متر واحد لأكتاف كانت تحمل السقف، وهي مبنية من اللبن قياس 3 × 34 × 8 سم ، كما وجدت في الركن الجنوبي الغربي للاصطبل حجرة صغيرة من الآجر المربع قياس 28 × 28 ×9 سم طولها 2 م وعرضها متر واحد، ولها مدخل عرضه 50 سم ربما كانت تستخدم لخزن بعض المواد الخاصة بالخيول.
وعلى امتداد الضلع الشمالية لهذه الوحدة قاعة مستطيلة الشكل 27 × 8،50م وجدت فيها بقايا ثلاث أكتاف من اللبن لحمل السقف إحداها ملاصقة للسور وهي على ارتفاع 2م، وجدت فيها من الأسفل حنايا صغيرة اتخذت بيوتاً للحمام في صفوف منتظمة الواحدة فوق الأخرى، كما وجدت في الركن الجنوبي الشرقي المواجه لهذه الدعامة حنيات دائرية بثلاثة صفوف الواحدة فوق الأخرى.
أما المعالف فتقع في الجدارين الشمالي والجنوبي من هذه القاعة، كما عثر في منتصف الضلع الجنوبية لهذه القاعة على بقايا سقاية فخارية لشرب الحيوانات.
ص: 437
أما الملحقات الأخرى لهذه الوحدة البنائية فهي عبارة عن ثلاث حجرات يصل إليها بمدخل تطل على الفناء الوسطي الجنوبية الشرقية منها أكبرها مساحة ربما استخدمت لتربية الطيور الداجنة وخزن الغذاء الخاص بها في مكان يجاور السور، ابعادها 12/25× 5م.
أما الحجرة المجاورة لها فهي مربعة الشكل طول ضلعها 5م، وجدت بها بيوت للحمام مكونة من ثلاثة طوابق فوق بعضها ، لكل طابق منها ستة بيوت.
أما الحجرة الثالثة التي تلي الحجرة الثانية فيبلغ اتساعها 2،80 × 30، 5م ، يرجح بأنها كانت تستخدم لحفظ بعض الأدوات الخاصة بالحيوانات.
أما الوحدة البنائية الثانية فتتكون من فناء واسع مربع الشكل طول ضلعه 16 م، على كل من جانبيه الشمالي والجنوبي حجرتان ربما استخدمتا لسكنى حرس وخدم هذه الدار.
أما الوحدة البنائية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فيتم الوصول إليها من مدخل عرضه 70، 1م وعلى جانبيه دعامتان مربعتا الشكل يؤدي إلى ممر طويل يفصل بينها وبين فناء القسم الرئيس من الدار عرضه 15، 2م ، ولكل من الوحدات الأربع مدخل مستقل يطل على هذا الممر، وتتصل ببعضها بمدخل عن طريق أفنيتها، وتتكون الوحدات الرابعة والخامسة والسادسة من فناء مستطيل الشكل، تطل عليه حجرتان من جهته الجنوبية.
اما الوحدة الثالثة فقد أغلق مدخلها وفتح بدلاً عنه مدخل آخر يؤدي إلى الحجرة الوسطى، وتتميز هذه الوحدة بوجود أعمدة جصية مندمجة تزين مداخل الأبواب المطلة على الرواق الذي يتقدم الحجرة الوسطى والحجرة الواقعة إلى الغرب منها، كما لوحظ في وسط الحجرة الوسطی انخفاض عمقه 7 سم مطلي بالجص كأرضية الحجرة نفسها.
ص: 438
ويضم القطاع الأوسط القسم الرئيس من الدار، ونصل إليه من خلال مدخل بني باللبن والجص قياسه 25×25×6 سم ، يقع غربي الفناء الرئيس، فتحته 2،25 م وعمقه 3 م ، يؤدي إلى مجاز طويل مستطيل 70، 11 × 5،25 م ، في نهايته مدخل سعته 2،25م وعمقه 2،35م يؤدي إلى فناء القسم الرئيس الذي تبلغ مساحته 52 × 31،20م ، وفي وسطه انخفاض ربما كان فيه فوارة ماء، وزينت واجهات الفناء بالأضلاع العمارية البارزة (الدخلات والطلعات) (الشكل 11)، عرضها متر واحد وتبرز عن الجدار حوالي 20 سم، والمسافة بين كل ضلعين نحو 2 م، وهي غير متساوية في الواجهة الشرقية ومتساوية في الواجهتين الشمالية والجنوبية.
ويطل القسم الرئيس من الدار على هذا الفناء من الجهة الغربية، اذتحيل مساحة مربعة الشكل تقريباً طولها من الشمال إلى الجنوب 20 ، 32م ومن الشرق إلى الغرب 30م (الشكل 12) ، يتوسطه إيوان (7) عمقه 30 ،10م وعرضه 6،10 م، يتقدمه رواقان، الرواق الأول (3) طوله 18،70 م وعمقه 5،10 م على كل من جانبيه حجرة مربعة طول ضلعها 5،10م ، تفتح على الرواق (1) بثلاثة مداخل اتساع الأوسط منها 2،50م واتساع المدخلين الجانبيين ،2م ، وطول هذا الرواق 20، 31م وعمقه 5،10م ، وهو مفتوح على الفناء بثلاثة مداخل اتساع المدخل الأوسط منها 65 ،2 م، واتساع المدخلين الجانبيين 05، 2 م ، والى الشمال من الضلع الشرقية لهذا الرواق دكة طولها 3،75م وعرضها 40 سم ، وفي منتصف الضلع الجنوبية لهذا القسم الرئيس من الدار مدخل اتساع فتحته 1،10م يؤدي إلى وحدة بنائية لم تكتشف بعد، وعلى كل من جانبي الإيوان (7) حجرتان مساحة كل منهما 30 ،10 × 20 ،5م، وفي مؤخرة الإيوان والحجرتين اللتين على جانبيه رواق (11) على كل من جانبيه حجرة ،مربعة، وهو شبيه بالرواق (3) والحجرتين اللتين على جانبيه في التخطيط والمساحة، ويفتح الرواق (11) على الفناء الخلفي بثلاثة مداخل سعة المدخل الأوسط منها 3،40م وسعة كل من المدخلين الجانبيين 1،50 م.
ص: 439
وقد تميزت الحجرة رقم 9 بسعة مدخلها المؤدي إلى فناء الوحدة البنائية الواقعة إلى الجنوب من القسم الرئيس للدار؛ إذ بلغت 80 3م ، كما تم العثور على آثار حفرتين في الأرض على جانبي هذا المدخل تشيران إلى أن لمدخله مصراعين.
ووجد مدخلها المؤدي إلى الحجرة رقم (8) مزيناً بعضادة تتألف من انحناءات مزدوجة تبدأ من أرضية الحجرة المتبقي منها إلى ارتفاع حوالي متر واحد. كما عثر في أرضية هذه الحجرة (9) على قطع من الطين عليها آثار القصب الذي استعمل في تسقيف هذا القسم من الدار، ويدل على أن سقفها كان مستويا.
أما باقي وحدات الدار (1) فتتكون من فناء كبير طوله من الشرق إلى الغرب 62،40م وعرضه من الشمال إلى الجنوب 60، 36م، يطل عليه القسم الرئيس من الجهة الغربية بخمسة مداخل ، ويبدو الفناء محاطاً بوحدات سكنية من جهته الشمالية والجنوبية، كما يبدو أن جهته الغربية تحوي مدخلاً خاصاً لهذا الفناء.
أما المدخل الغربي لهذه الدار فهو بمنتصف سورها الغربي تقريبا، وهو شبيه بالمدخل الرئيس الا أنه أصغر مساحة منه، ويخلو الدكاك قائم على دكة من اللبن، وهو مبني باللبن أيضاً ومدعم من الخارج ببرجين مربعي الشكل تقريباً 1،70 × 1،90م سعة فتحته 2،55 م تؤدي إلى مجاز أبعاده 9،20 × 5،20 م وسعة فتحته الثانية 3،20م تؤدي إلى الفناء الغربي (الشكل 13).
ومن الملاحظات التي لا بد من ذكرها هو عدم العثور على زخارف جصية تزين جدران هذه الدار وندرة اللقى الأثرية فيها، والراجح أن السبب يعود
ص: 440
إلى هجر مدينة المتوكلية قبل إتمام عملية بنائها، كما هو الحال في العديد من دور المدينة.
ومن الظواهر العمارية التي نشاهدها في هذه الدار :-
1 - إحاطتها بأسوار مرتفعة مدعمة بالأبراج والدعامات المبنية بكتل الطين (الطوف) بهيئة صفوف أفقية.
2 - تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات طويلة متوازية، وهذا الطراز تميزت به معظم دور وقصور مدينتي سامراء والمتوكلية، وترجع أصوله إلى العمارة العراقية القديمة الا انه لم يصل إلى درجة التطور التي وصل إليها في العصور الإسلامية، ومن الأبنية الإسلامية التي يتمثل بها هذا الطراز ، والتي تسبق بناء مدينة سامراء، دار الإمارة في الكوفة وقصر المشتى وقصر اسكاف بني جنيد وقصر الأخيضر.
3- ضمت هذه الدار مسجداً صغيراً داخل جدرانها (مصلى) احتوى على محراب مجوف ذي قطاع دائري، وميزة بناء مساجد صغيرة أو مصليات داخل قصور ودور الميسورين ظاهرة معروفة في العصرين الأموي والعباسي سبق وشاهدناها في قصر الحلابات 104 ه_ أو 105 ه_، وحمام الصرح ، وقصر المشتى في بلاد الشام في العصر الأموي، أما في العراق فإن أقدم مسجد تم الكشف عنه هو مصلى قصر الأخيضر، وفي مدينتي سامراء والمتوكلية عثر على عدد من المصليات في العديد من قصورها والدور الكبيرة فيها (1).
4 - ومن الظواهر العمارية المهمة التي ضمتها هذه الدار، وجود حمام ذي تقسيم ثلاثي مكون من ثلاث حجرات الحجرة الباردة والحجرة الدافئة والحجرة الساخنة وهي القريبة من الموقد، وهو النظام الذي سبق وشاهدناه في القصور الأموية في بلاد
ص: 441
الشام كقصير عمره وحمام الصرح ، وحمام قصر الحائر الشرقي، وحمام قصر الحائر الغربي، وكما رأيناه أيضاً في قصر الأخيضر وحمام البركة الدائرية في قصر المعتصم (باب العامة) (1).
5- ومن الظواهر العمارية الاخرى التي نشاهدها في هذه الدار هي المدخل المزور (المنكسر) الذي تميزت به معظم دور مدينتي سامراء والمتوكلية، ولهذا النوع من المداخل فائدتان، أولهما حجب من بداخل الدار عن أعين الغرباء، وثانيهما كسر حدة الرياح المحملة بالأتربة والرمال من الدخول إلى داخل الدار.
6- ومن الظواهر العمارية التي تشترك بها معظم دور قصور مدينتي سامراء والمتوكلية هو وجود إيوان على جانبه حجرتان، ويتقدمهم في معظم الأحيان رواق يفتح على الفناء بثلاثة مداخل، وهو ما أسماه المسعودي بالحيري(2)، وترجع أصول هذا الطراز إلى العمارة العراقية القديمة، ولعل اوضح صورة له نجدها في دور مدينة الحضر (3)، وقد استمر الأخذ بهذا التخطيط في الفترات اللاحقة التي تسبق بناء مدينة سامراء، فنجده في تل أبو شعاف في حوض سد حمرين الذي يعود إلى الفترة الساسانية، وفي العصر الإسلامي نراه في دار الإمارة في الكوفة، وفي أبنية مدينة البصرة القديمة، وفي الأبنية العباسية في منطقة الحيرة، وفي قصر الأخيضر ، واستمر الأخذ بهذا الطراز خلال العصر العباسي وبعده.
ص: 442
الصورة

ص: 443
الصورة

ص: 444
الصورة
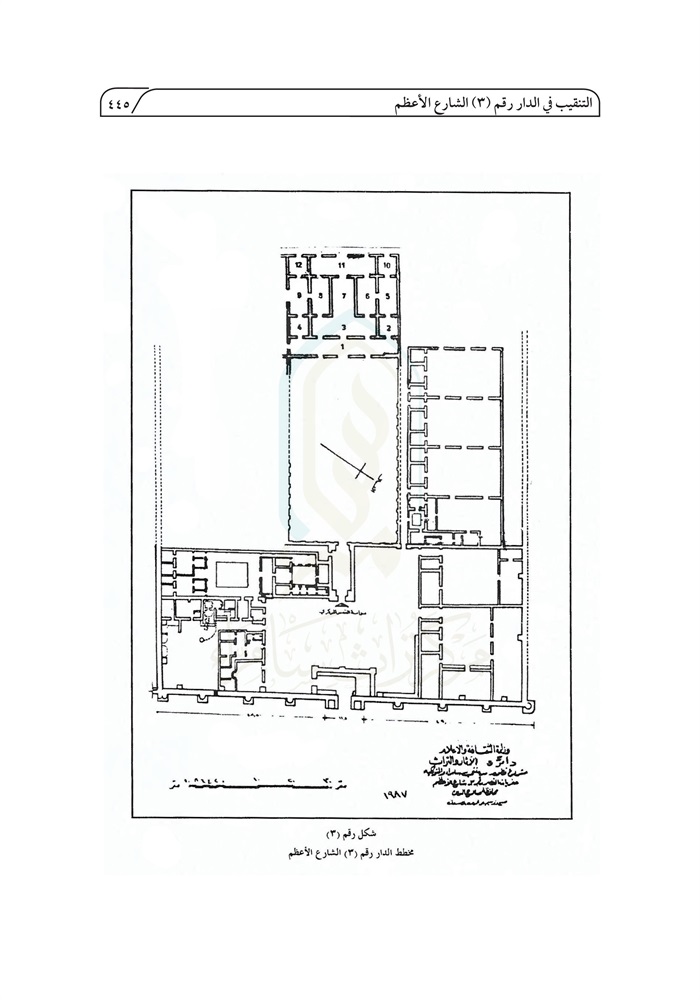
ص: 445
الصورة
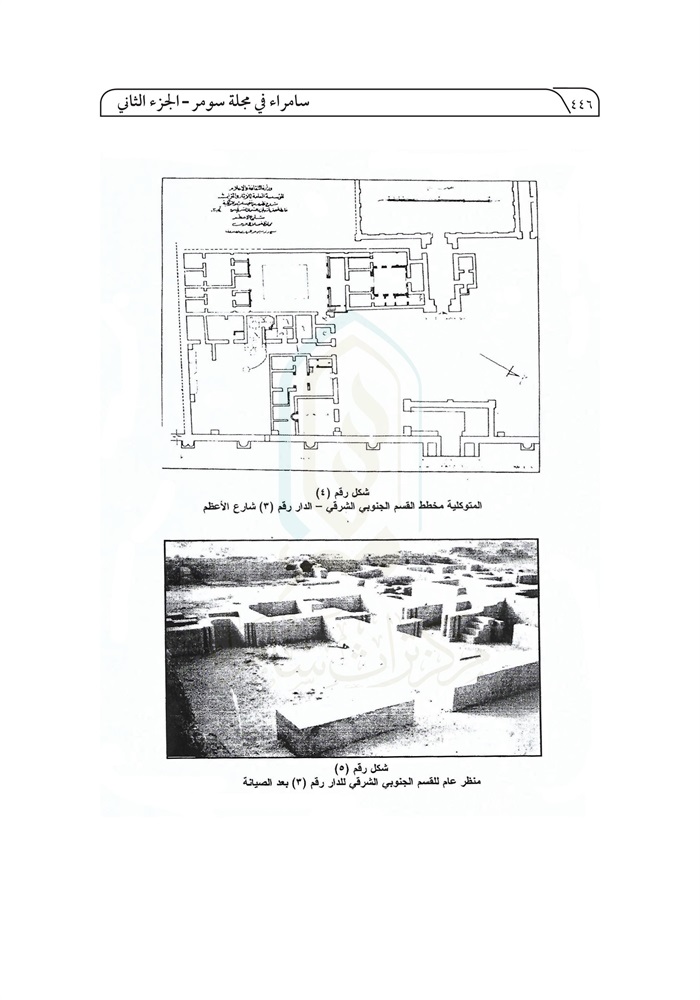
ص: 446
الصورة

ص: 447
الصورة
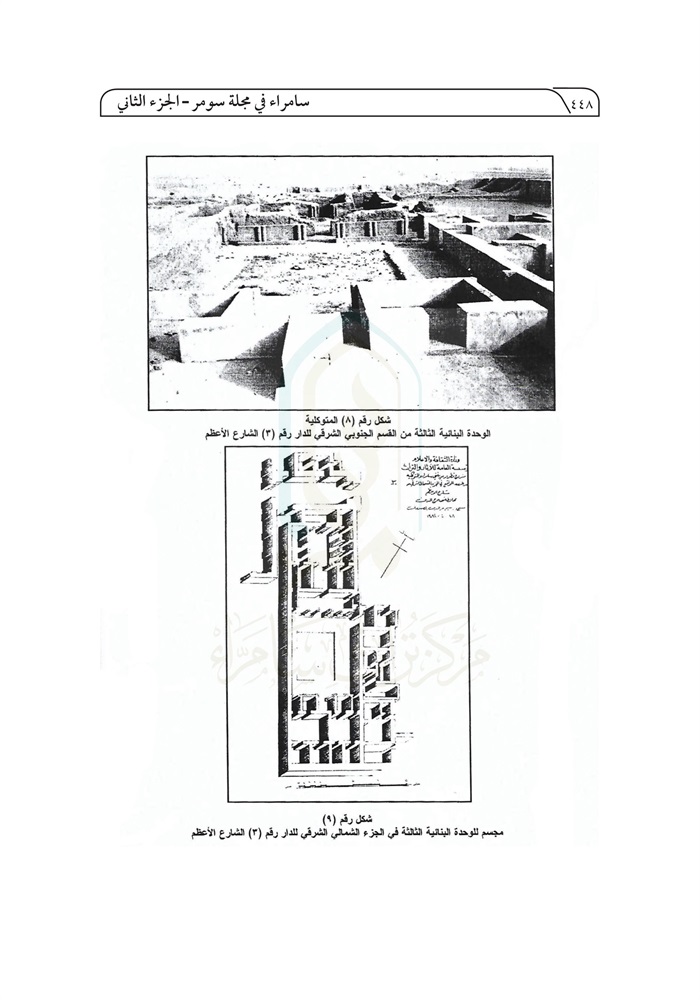
ص: 448
الصورة
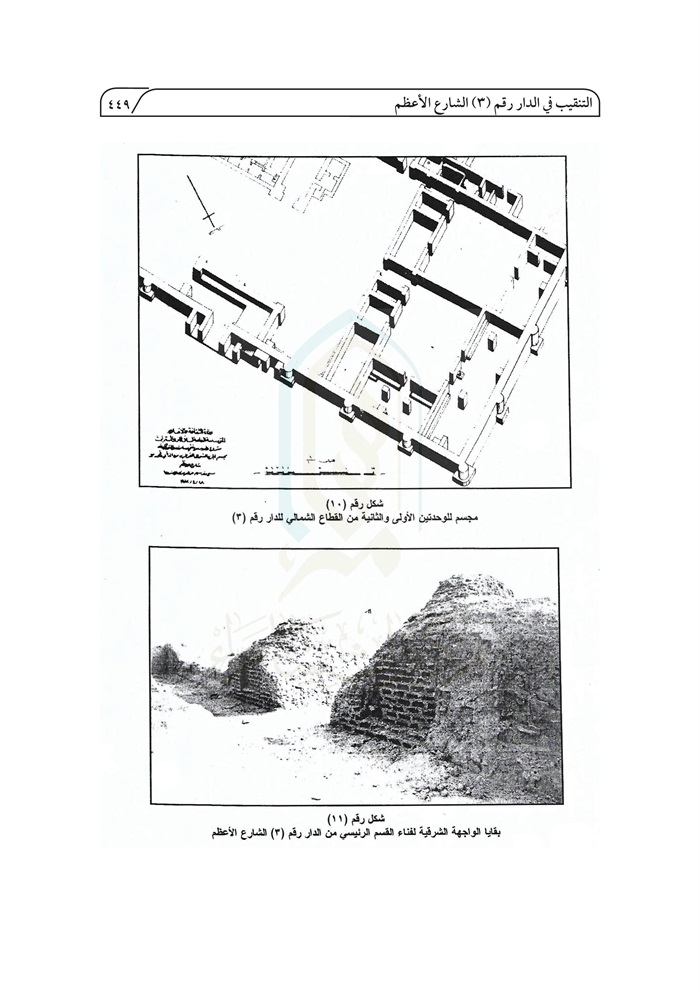
ص: 449
الصورة
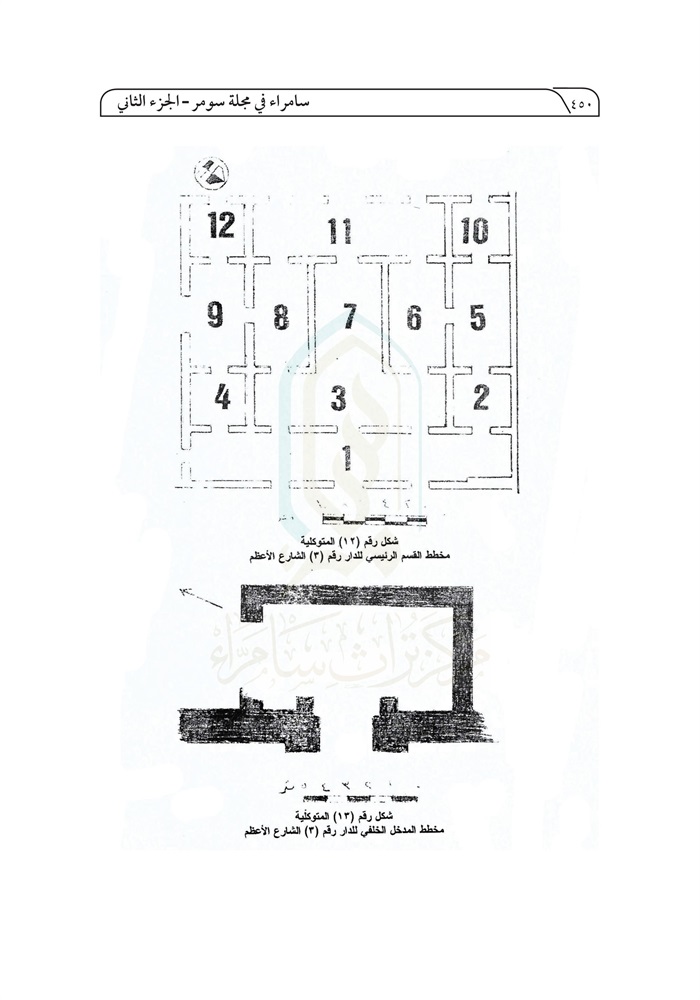
ص: 450
المجلد الحادي والخمسون سنة 001 2001 - 2002م
ربيع محمود القيسي
مقدمة
تمسكت في بحثي هذا تناول إحدى الإسهامات التي تشير إلى التفاعل الحضاري وعمق التأثير المعماري الفني الجميل من خلال دراسة إحدى الحالات التي حصلت في القرن الثالث الهجري، وأقصد بتلك الحالة هي تأثر عمارة جامع أحمد ابن طولون في القاهرة بالتخطيط العمراني والفني بعمارة الجامع الكبير المعروف بجامع الملوية في سامراء.
التأثيرات.
لا أريد التحدث بإسهاب عن الذي تناولته أفكار المؤرخين والمعنيين من تفاصيل بخصوص الجامعين المذكورين؛ لأنهم بحق قد أغنوا الموضوع حقه الشامل والمفيد، ولكن وددت أن أنقل الصورة الدقيقة من ملاحظاتي الميدانية عند زيارة جامع ابن طولون، ومقدار التأثير وأوجه الشبه من الناحيتين التصميمية والزخرفية.
صحيح ان أحمد ابن طولون قد ولد في بغداد ونشأ وترعرع في سامراء في عهدي المعتصم والمتوكل اللذين أوليا عناية فائقة لفن العمارة والزخرفة، فكان من الطبيعي تأثره في حب نقل هذا التراث المميز إلى القاهرة، عند توليه إمارة مصر، لينفرد بتشييد جامعه المعروف باسمه ويصبح ثالث جامع في العالم الإسلامي مشهور بمنارته الحلزونية بعد جامعي المتوكل وابي دلف في سامراء، والتي استأثرت باهتمام
ص: 451
عجيب من الباحثين والدارسين.
إن هندسة جامع ابن طولون قد تأثرت إلى حد كبير بتصاميم جامع سامراء الكبير الذي بدأ تشييده الخليفة المعتصم وبقي إلى أيام الخليفة المتوكل، حتى ضاق على الناس فهدمه وبنى مسجداً جامعاً واسعاً، كما أشار إلى ذلك اليعقوبي في كتابه البلدان، وكان ذلك في سنة 234 ه_ ، وفرغ من بنائه سنة 237 ه_، فأضحى بسورين سور خارجي مشيد باللبن أبعاده 440×376م يدعمه 68 برجاً، من بينها أربعة 68 كبيرة في الأركان وسور داخلي مشيد بالآجر أبعاده 240 × 156م، مدعوم ب_ 44 برجاً أربعة منها كبيرة في الأركان.
أما جامع ابن طولون فقد شيد سنة 263 ه-، وفرغ من بنائه سنة 265 ه_، ويتألف من سور خارجي مشيد بالآجر أبعاده حوالي 162،5 × 161،70م خالٍ من الأبراج الساندة، ويلاحظ انعدامه في جهة الجنوب الشرقي (جهة القبلة)، وسور داخلي مشيد بالآجر، ويخلو من الأبراج أيضاً، وأبعاده 122 × 118م تقريباً.
ولقد أصاب جامع سامراء الخراب وأزيلت معظم معالمه، الأمر الذي استوجب حتمية استقصاء دراسة العناصر العمارية والزخرفية في جامع ابن طولون الذي لا زال يحتفظ ببقايا أصلية على الرغم مما طرأ عليه من فترات تجديد للأجزاء المتهدمة في العهدين الفاطمي والمملوكي، ومن نتيجة المقارنات سواء للأقوال التي رددها المؤرخون العرب كالمقدسي والقضاعي والمقريزي وابن دقماق واليعقوبي والحموي والمستوفي ،وغيرهم، أو أولئك المهتمون الذي أجروا التحريات الأثرية والمشاهدات العينية من ذلك يمكن التأشير العلمي والدقيق لمجمل العناصر الفنية التي فقدها الجامع الكبير في سامراء عن طريق دراستها في جامع ابن طولون والذي لا زال مستخدما لأداء فريضة الصلاة بأوقاتها الخمسة حتى يومنا هذا.
وفيما يأتي ملخص لأوجه الشبه في عمارة المسجدين المذكورين: -
ص: 452
*الجامعان مشيدان طبقا للنهج المتبع في تشييد جوامع صدر الإسلام، وكان صلى الأساس مسجد سيدنا الرسول محمد صلّی الله علیه و آله.
*يضم جامع سامراء في داخله أساكيب للصلاة عددها تسعة في جهلة القبلة، وأربعة في كل من المجنبتين، وثلاثة في المؤخرة، أما جامع ابن طولون فيضم خمسة أساكيب في جهة القبلة، واثنين في كل من المجنبتين والمؤخرة (صورة 1).
*أساكيب الصلاة في كلا الجامعين تنفتح على فناء واسع تتوسطه نافورة وحوض للماء، ذكرها اليعقوبي في جامع سامراء بقوله « وجعل فيه فوارة ماء لا ينقطع ماؤها. ووصفها المستوفي بأنها كانت من قطعة واحدة من الحجر محيطها 23 ذراعا وارتفاعها سبعة أذرع وثخنها نصف ذراع وكانت تعرف بكأس فرعون. وفي جامع ابن طولون نجد مثيلاً لها قد جرت ترميمات في العهد المملوكي فأصبحت مشيدة بحجارة مهندمة بهيئة مكعب متوج بقبة وفي جوانبه تؤدي إلى حوض حجري (صورة 2).
دعامات ضخمة تتواجد في أساكيب بيت الصلاة تحمل السقوف، ظهرت نتيجة التنقيبات التي جرت مؤخراً في جامع سامراء بأن عددها 480 دعامة بعد أن كان يظن أنها 464 دعامة وجميعها مشيدة بالآجر وشكل كل منها مثمن في جوانبه الأربعة يقوم عمود اسطواني من الرخام يعلوه تاج منقوش. هذا ما أفادنا به الأستاذ الألماني هرتسفيلد الذي أجرى في بداية القرن الماضي تحريات كبيرة في المنطقة وعثر على دلائل ثابتة. ومن خلال التنقيبات التي أجرتها دائرة الآثار والتراث في بداية الستينات من القرن الماضي في الجامع تم العثور على عدد من تلك الأعمدة الرخامية كانت مدفونة في الأتربة.
نجد اتباع نفس الأسلوب المعماري في جامع ابن طولون ولكن الدعامات، وعددها 160 دعامة، تكون مستطيلة ومنشورية الأركان، والتي تقوم عنها أعمدة
ص: 453
اسطوانية شيدت بالآجر دون الرخام بطريقة التعشيق مع الأجزاء الأخرى للدعامة، وتنتهي الأعمدة بتيجان منقوشة (صورة 3).
الدعامات في جامع ابن طولون تحمل عقوداً مدببة تبدأ من تيجان الأعمدة لترتكز فوقها الأخشاب المزخرفة للسقف المستوي (صورة 4)، والتي يحف به من الأسفل بقايا أزار من الخشب يلتف حول أساكيب بيت الصلاة في عموم الجامع حفر فيه حفراً بارزة آيات من القرآن الكريم بالخط الكوفي (صورة 5)، ويلاحظ أن تلك العقود والدعامات منفتحة بصورة مباشرة وبدون حواجز على صحن الجامع (صورة 2). في حين ان الاشارات التاريخية عن جامع سامراء تؤكد على وجود الحاجز وخلو أساكيب بيت الصلاة فيه من العقود حيث ترتكز أخشاب السقف مباشرة على الدعامات.
في جامع ابن طولون نماذج كثيرة لطرز سامراء الزخرفية تنتشر وتتكرر في بواطن وظواهر العقود والدعامات وتيجان الأعمدة والنوافذ الداخلية والسقوف الخشبية بل وحتى أخشاب المداخل على الرغم من حداثتها (صورة 5،6).
ان العقود الموجودة في المجنبتين من جامع ابن طولون تتعامد بصفوف متوازية باتجاه القبلة، أما في بيت الصلاة والمؤخرة فتتوازى بالاتجاه المعاكس، وهذا الأسلوب يشابه ما هو موجود في جامع أبي دلف في سامراء.
شيدت منارة جامع ابن طولون بأسلوب مشابه لملوية سامراء وخاصة في السلم الذي يرتقي خارج البدن يدور عكس اتجاه عقارب الساعة بشكل مألوف في جميع مآذن المساجد الإسلامية التي تشاد سلالمها عادة داخل البدن (صورة 7).
تقع المنارة خارج الضلع الشمالية الغربية للجامع في منطقة لا تتعامد مع المحراب كما هو الحال في جامع سامراء. وتظهر حاليا بقاعدة مربعة مشيدة بالحجارة ارتفاعها حوالي 21م ، يعلوها طابق اسطواني مشيد بالآجر 9 م ، ثم طابقان مثمنان متراجعان
ص: 454
مشیدان بالحجارة وينتهي ثانيهما بقبة صغيرة مضلعة وعند ذاك يكون ارتفاعها نحو 40 م، ولقد طرأت عليها تجديدات بنائية في العهدين الفاطمي والمملوكي خاصة في عهد السلطان لاجين المملوكي، الأمر الذي يشير إلى احتمالية تقوية الأجزاء الاجرية المتهدمة والتي هي من فترة البناء الطولوني، بالحجارة مما قد يشير إلى التغيير في الشكل الأصلي للمنارة، أما ملوية سامراء فتعد من أضخم المنائر التي شيدت بالآجر في العصور الإسلامية الأولى، فهي قائمة على قاعدة مربعة بارتفاع نحو 50م ومؤلفة من خمس طبقات يلف حولها مرقى حلزوني يؤدي إلى قمة المنارة.
ويرى عدد من الباحثين ان المنارة الملوية لم يكن لها نظير من قبل ولا من بعد، وأنها ومئذنة جامع ابن طولون لا تتشابهان الا في وضعية المرقي الخارج في كل منهما. وان القاعدة الحجرية المرتفعة لمنارة ابن طولون والتي تمثل الطابق الأول، تزين جوانبها الأربعة طاقة مزدوجة في وسطها عمود صغير رشيق يرتقي عليه عقدان منفوخان على هيئة العقود الأندلسية ولكن المتتبع في الطبقة الثانية لمئذنة ابن طولون والتي شيدت بالآجر يجعلنا نعتقد على الأكثر بان الطبقة الأولى الحالية ربما قد حورت وأضيفت على القاعدة الأصلية المشيدة بالآجر وان ذلك التحوير بالحجارة قد جرى في عهود لاحقة من فترات التجديد والتقوية والا كيف يمكن تعليل بناء طبقة ثانية بالآجر . ثم إضافة طبقتين أخريين بالحجارة، آخذين بنظر الاعتبار ان المواد المستخدمة في بناء عموم الجامع هي من الآجر والجص.
ويقول الدكتور فريد الشافعي في مقالة بعنوان (مئذنة مسجد ابن طولون) (1) بان موجة قوية وافدة من الغرب الإسلامي كان لها الفضل الأكبر في الايحاء بتلك القاعدة الضخمة المربعة لمئذنة مسجد ابن طولون هذا وقد اشترك مع ذلك الايحاء الغربي الإسلامي عامل مترسب في تقاليد عراقية قديمة، وهي فكرة السلم الخارجي الذي كان موجودا في بقايا المئذنة التي كان قد أنشاها ابن طولون مع مسجده،
ص: 455
وأغلب الظن ان تلك البقايا كانت قائمة في وقت البدء في بناية المئذنة الجديدة التي حلت محلها.
المداخل الموجودة في أضلاع السور الداخلي للجامع الكبير في سامراء عددها 17 مدخلا بعضها أحدث في فترة لاحقة وخاصة في الضلع الغربية بسبب ظهور الحاجة إلى استحداثها لزحمة المصلين، ويمكن اعتبار اثنين منها والموجودة في الضلع الجنوبية على جانبي المحراب من المداخل الخاصة وربما كانت لدخول الامام أو الخليفة عند قدومه للصلاة. ومما يجدر ذكره إن مثل تلك المداخل نجدها في جامع أبي دلف في سامراء بينما لا نجد مثلها في كثير من مساجد المدن الإسلامية كالكوفة وواسط.
أما جامع ابن طولون فيحتوي سوره الداخلي على 21 مدخلا تؤدي إلى اساکیب بيت الصلاة لها أبواب خشبية كبيرة كل منها بمصراعين منقوش فيها طرز سامراء الزخرفية. كما يلاحظ وجود أبواب صغيرة في جهة المحراب تؤدي إلى الخارج. ويذكر المقريزي وجود باب من جدار الجامع يسلك منها إلى المقصورة المحيطة بمصلى الأمير بجوار المحراب هذا بالإضافة الا انه في السور الخارجي، الذي ينعدم في جهة القبلة والذي هو دون مستوى السور الداخلي في الارتفاع، أبواب كل منها تقابل بابا في السور الداخلي (صورة 8).
الواجهات الخارجية لأضلاع جامع سامراء من الأعلى تزينها مشكاوات مدورة ومقعرة قطرها متر واحد، ومؤطرة باجر منتظم رصف بوضع مائل على جوانبه ليشكل إطاراً مربعاً ضلعه 1،70 م (صورة 9) ، وقد استخدمت نفس الفكرة في جامع ابن طولون مع تغييرات بسيطة من حيث الحجم والأسلوب، فأصبحت الزخرفة الدائرية أصغر وتحصرها أطر آجرية بارزة ومربعة الشكل وهي مفتوحة على ثخن الجدار وليست صماء كما هو الحال في سامراء. ويعلو هذه الزخرفة شرفات مخرمة متقاربة كالمغازل لها ما يماثلها في قصور سامراء وقد اختلف الكتاب في وصفها
ص: 456
فشبهوها بالعمامة وألسنة اللهب وشنف الديك والراقصات والاقزام (صورة 9، 10).
في الواجهات العليا للجدار القبلي من جامع سامراء توجد 24 نافذة تتوزع على جانبي المحراب حيث تكون 12 نافذة في كل جانب، مهمتها كانت للتهوية وإضاءة حرم الصلاة الواسع، وكل نافذة بهيئة مشكاة تنخسف عن مستوى وجه الجدار ومحاطة باطار مستطيل ارتفاعه 2/5 و عرضه 1/90م حيث تنفذ فتحتها داخل خلال أنصاف أعمدة جانبية تحمل عقداً مفصصاً من خمسة أنصاف دوائر ، أعلاها تشكل قمة العقد ولا يوجد من هذه النوافذ في بقية الأضلاع باستثناء اثنتين في جنوب كل من الضلعين الشرقية والغربية قد فتحت في وقت لاحق. كما تشير الدلائل الأثرية ان مداخل الجامع كان يعلوها مثل تلك النوافذ وإن لم تكن تحمل نفس المواصفات الزخرفية.
وقد استخدم هذا الأسلوب المعماري في جامع ابن طولون حيث انتشرت النوافذ على طول الأضلاع وعددها 128 نافذة وتكون من الداخل بهيئة عقود مدببة ومنقوشة ترتكز على أنصاف أعمدة ، وقد روعي في إحكام غلق الفتحات شبابيك جصية مزخرفة مركبة داخل الطاقات ( صورة 5).
وقد أنشئت مثل تلك الفتحات عند مناطق التقاء العقود التي تحملها الدعامات الضخمة الموزعة في أساكيب الصلاة وذلك لتخفيف الاوزان (صورة 7).
ص: 457
الخاتمة
كانت بلاد الرافدين المفتاح الأول للتجارب البشرية ومصدراً للإشعاع الحضاري والإنساني حيث بلغت مبلغاً لا سبيل إلى مقاومته في غزو العالم القديم. وما تقدم في البحث الموجز هو أنموذجاً حياً لا زال باقياً يتحدى الزمن، ويعد عاملاً من عوامل التواصل الحضاري بين شتى أجزاء الوطن العربي والعالم الإسلامي، فالوطن العربي يوحده عدد من العناصر التي جمعت السكان في إطار بشري واجتماعي واقتصادي وفكري وحضاري والتشابه لدرجة كبيرة في شتى بقاعه المتباعدة.
ص: 458
الصورة

ص: 459
الصورة
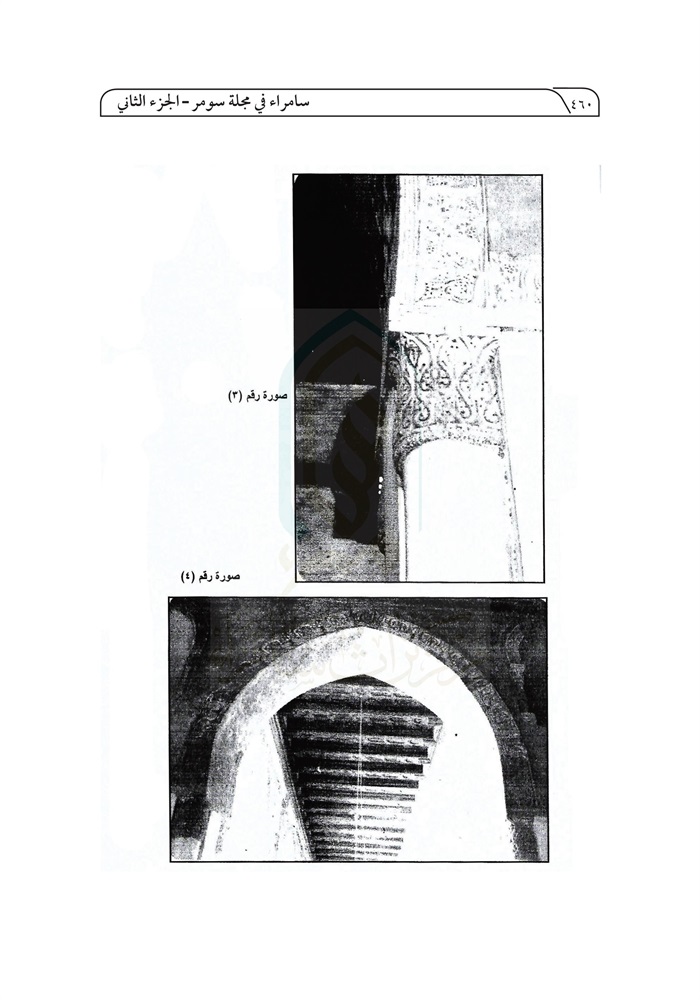
ص: 460
الصورة
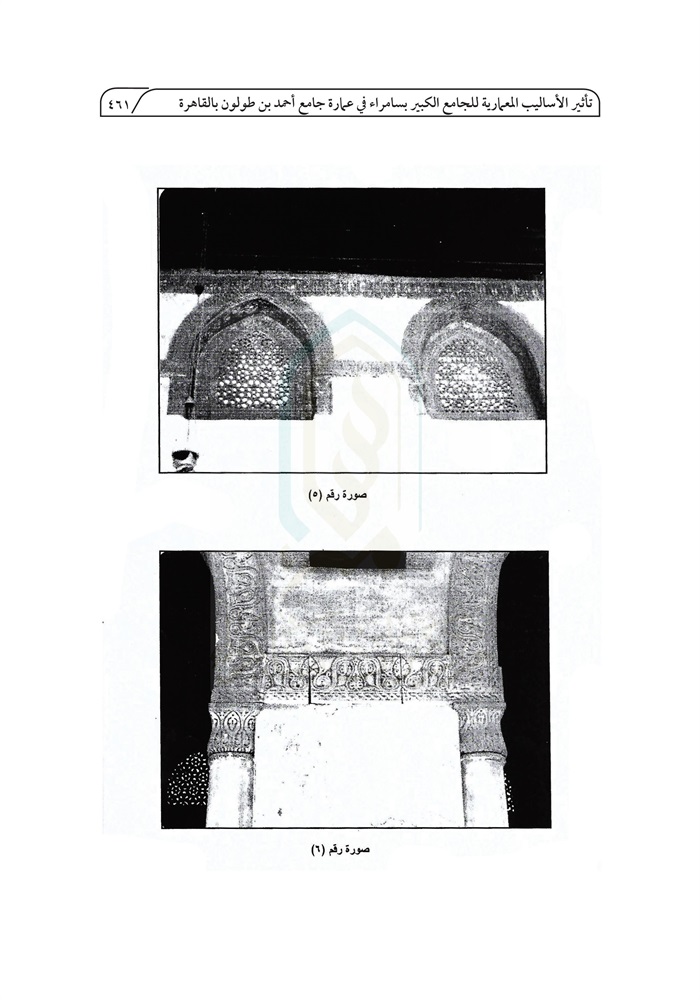
ص: 461
الصورة
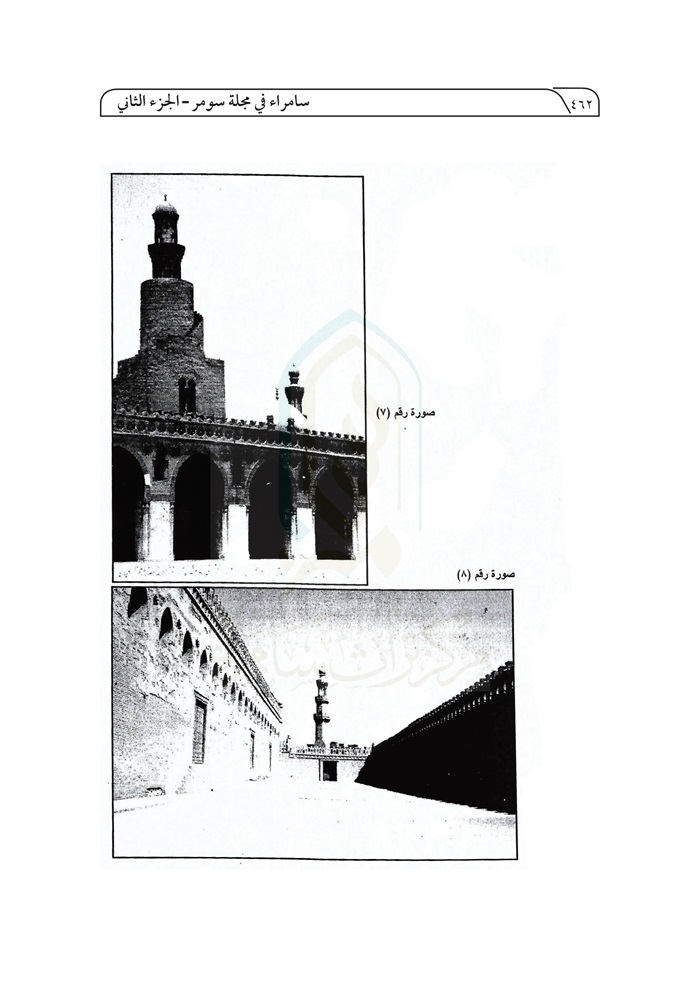
ص: 462
الصورة
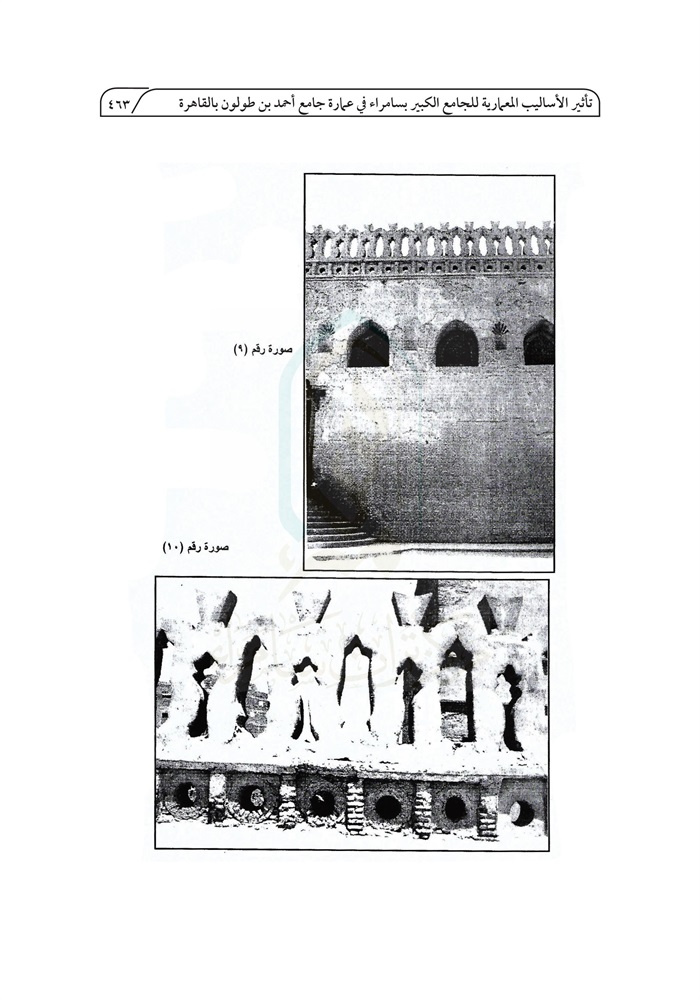
ص: 463
ص: 464
المجلد الحادي والخمسون سنة 2005 - 2006 م
د. إساعيل محمود السامرائي
اختصاصي آثار
تقع البركة في قصر الخلافة الجوسق الخاقاني إلى الشمالي الشرقي من باب العامة المطل على نهر دجلة الذي يعد المدخل الرئيس لدار الخلافة العباسية الذي بناه الخليفة العباسي المعتصم بالله عند نقله العاصمة العباسية من بغداد إلى سامراء وأسس عاصمته الجديدة سامراء عام 221 ه_ / 834م .
لا يعرف بالتحديد تاريخ إنشاء البركة إلا انه يمكن أن يؤرخ بناؤها بتاريخ قصر الخلافة. الواضح من بناء البرك هو لقضاء ساعات النهار الحارة داخل البرك أسفل مستوى الأرض إذ إن إنشاء أحواض للسباحة وملأها بالماء وأرقاع جدران الغرف والاواوين والقاعات وبناءها بشكل متناظر حول الحوض الدائري وبالاتجاهات الأربعة وفتح هذه القاعات والأواوين بعضها على البعض الآخر بواسطة ممرات داخلية كل ذلك يخلق جواً لطيفاً رطباً بارداً أوقات الظهيرة في فصل الصيف داخل الغرف والأواوين والقاعات يجنب الناس حر الظهيرة وحرارة الشمس إضافة إلى أن الإنسان يتخلص من همومه ومشاكله عندما يسبح ويلهو ويستريح.
إن نظام بناء المخابئ أو السراديب استمر العمل به في بيوت العراقيين وإلى وقت قريب، ففي مدينة سامراء يقوم الناس بحفر ألسراديب العديدة في البيت الواحد أسفل مستوى الأرض يفتح بعضها على البعض الآخر بواسطة ممرات ينزل بها الناس يقضون فيها أوقات الظهيرة الحارة لعدم وجود وسائل التبريد الحديثة والكهرباء.
ص: 465
لذا ازداد اهتمام الخلفاء بالبرك وبنائها وأصبحت من العناصر المعمارية المتميزة بتخطيطها وهندستها وبنائها في العمارة الإسلامية.
اذن لما كان الغرض من إنشاء البرك هو لقضاء ساعات النهار الحارة داخلها تخلصاً من حرارة الشمس فليست هناك حاجة إلى إنشاء برك ليلية مكشوفة كما أورد ذلك بعض المؤرخين الذين اعتبروها بركة ليلية مكشوفة واعتبروا بركة الحير الواقعة إلى الشرق من باب العامة في نهاية قصر الخلافة انها مسقفة وتستخدم بالنهار - حيث إن الآثريين لم يعثروا على أية دلالة معمارية أثرية يمكن أن يستدل بها على أن الحير كان مسقفا ويستخدم بالنهار والبركة مكشوفة، لكن الراجح ان المكانين استخدما لقضاء ساعات النهار الحارة إضافة إلى أن سطوح المنازل في الليل والساحات المكشوفة داخل البيوت كافية لتوفير الجو المعتدل لتشعر الإنسان بالراحة والسكينة وعدم الضجر من حرارة الجو.
كما ان هناك سبباً آخر يدعو لعدم استخدام البرك في الليل، إذ إن عدم توفير الإنارة الكافية داخل غرف وقاعات و أواوين البركة في الليل لا يشجع على استعمالها ليلاً، ولنفترض أن الإنارة توفرت في الليل بشكل كافٍ الا ان مصادرها تكون الزيوت المحروقة، وبناية مثل البركة تحتاج إلى كميات كبيرة من الزيوت لحرقها، وهذا ما سوف يؤدي إلى انبعاث روائح ودخان كثير يؤثر على الجو العام داخل البركة تزعج الموجودين داخلها هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية ما هو الدليل الذي استند إليه المؤرخون في اعتبار الحير بركة نهارية مسقفة والبركة المكشوفة ليلية.
من كل ما تقدم يمكن ان نسنتتج ان الحير هو بركة كان يستخدمها القادمون إلى دار الخلافة من عامة الناس لحين مقابلة الخليفة لقضاء حاجاتهم وحل مشاكلهم. وان البركة الكبيرة هي لقضاء الخليفة وحاشيته والوفود الرسمية التي تفد إلى قصر
ص: 466
الخلافة ساعات النهار وقت الظهيرة، أو للاستمتاع بالراحة والسباحة والبرودة، كما هو حال الحير.
المميزات المعمارية
تحتل البركة مساحة من الأرض تألفت من طابقين الطابق الأسفل بني في باطن الأرض بعد أن حفرت له مساحة في الأرض الصخرية بلغت أبعادها 122/5م من الشمال إلى الجنوب و 132/5 م من الشرق إلى الغرب تربو مساحتها على140/000م (مخطط - 1).
اما الطابق الأعلى فقد بني فوق سطح الأرض ولم يتم الكشف عن تفاصيله المعمارية بالكامل. يحيط به سور دعم بأبراج نصف دائرية بلغت أبعاد السور 180 x 180م، مبني بالطابوق والجص بلغ سمكه 1,55م.
يتوسط بناية البركة حوض ماء دائري حفر على عمق 13 متر تحت مستوى سطح الأرض غلفت أرضية الحوض وجدرانه بالمرمر لمنع تسرب المياه إلى أبنية البركة والمتمثلة بقاعاته وممراته وخلواته وأواوينه كما وضعت في أسفل حافة جدران الحوض المرمرية أنابيب فخارية استخدمت لصيد الأسماك أو تكاثرها حيث عثر على هياكل عظمية لأسماك بداخلها.
يحيط بالحوض الدائري ممر مكشوف بلغ عرضه 7 أمتار وبلطت أرضيته بالطابوق الفرشي قياس 50×50×7 سم يفصل الحوض الدائري عن أبنية البركة.
أما أبنية البركة أي الطابق الأسفل فيها، فتتألف من العديد من القاعات والغرف والممرات عددها (20 قاعة وغرفة ) ، بنيت بمادة الطابوق والجص بشكل متناظر في الجهات الأربع الرئيسة، والتي يمكن الوصول إلى كل جهة منها بواسطة مدخل رئيس فتحت في الجهات الأربع ينزل منها بواسطة سلالم هابطة.
ص: 467
أزرت جدران القاعات الرئيسة الواقعة في نهاية السلالم والتي تمثل أشكالها النظام الحيري في البناء بزخارف جصية بارتفاع (1) متر) تمثل طراز سامراء الأول من طراز الزخرفة الثلاثة التي نشأت في سامراء. وهي عبارة عن مجموعة زخرفية حفرت بالحفر العميق تمثل عناقيد وأوراق العنب وضعت داخل إطار زخرفي أيضاً زخرف بحبات اللؤلؤ.
وشغلت أركان بناية البركة وحدة بنائية مؤلفة من مجموعة غرف تمثل الحمامات ودورات المياه.
يغذي البركة بالمياه كهريز يقع في الجهة الشرقية للحوض، يأخذ مياهه من النهروان (نهر الرصاصي ، وبعد أن يعكر الماء ويتوسخ يخرج بكهريز ثان يقع قبالة الكهريز الأول من الجهة الغربية ينصرف منه الماء إلى نهر دجلة.
إن بناية البركة أصابها التشويه والتخريب في جدرانها وبياضها وسطوحها نتج من عدم تسوية سطوحها أو تغليفها وتركت الغرف والقاعات لا يحمي سقوفها سوى طبقة خفيفة من الجص مما أدى إلى تسرب مياه الأمطار في فصل الشتاء إلى جدرانها وظهور الرطوبة العالية في بياض الجدران أو تساقط مساحات كبيرة منه إضافة إلى كتابات الذكرى التي سجلها الزائرون للموقع على الجدران بمادة الفحم فكان التشويه والتخريب واضحاً بحيث لا يتلاءم وموقع البركة الأثري.
كما ان الحوض الحجري الدائري هو الآخر أصابه التشويه والتخريب نتيجة تساقط كميات كبيرة من الحجر الذي غلف به كل ذلك تطلب تشكيل هيئة فنية أثرية لإعادة صيانة ما تعرض للتخريب.
أجرت البعثة كشفاً سريعاً لموقع البركة للوقوف على الأماكن التي يكون لها الأولوية في الصيانة، وكانت اسبقية العمل للأماكن التي تحتاج إلى صيانة سريعة وهي:
ص: 468
1 - الحوض الدائري
يؤلف الحوض الدائري شكلاً دائرياً محفوراً في الأرض الصخرية الطبيعية وسط بناية البركة من الأسفل يبلغ قطره (62م) وبعمق يتراوح بين 2-2/10م عن أرضية بناية البركة. ويبلغ عمقه عن الأرض الطبيعية أرض قصر الخلافة مسافة (13م) (صورة1).
يغذي الحوض الحجري الدائري بالمياه كهريز أشبه بساقية الماء، بني بمادة الطابوق الفرشي والجص المخلوط بالنورة لغرض مقاومته للرطوبة، يأخذ شكله الشكل البرميلي الأسطواني، معقود من الأعلى بعقد مدبب، يستمد الكهريز مياهه من أحد الأنهار التي أحياها الخليفة المتوكل على الله المسمى النهروان (نهر الرصاصي)، الواقع إلى الشرق من قصر الخلافة والبركة بحوالي (10 كم) (صورة - 2).
ولما كان النهروان أكثر ارتفاعا من منطقة قصر الخلافة والبركة فكانت مياهه تنساب بشكل طبيعي إلى داخل الكهريز لتصل إلى قصر الخلافة والبركة بطريقة (الأواني المستطرقة) المعروفة.
كان الحوض الحجري يملأ بالمياه بهذه الطريقة، ويستخدم على الأغلب للسباحة والراحة والنزهة، وبعد ان تتوسخ المياه داخل الحوض ويراد تبديلها فإنها تتصرف إلى خارج الحوض بواسطة كهريز آخر يقع قبالة الكهريز الأول من الجهة الغربية، وكانت هذه الكهاريز على الأغلب قد سدت مداخلها بأبواب أشبه (بالسقاطات) المستخدمة حالياً في المشاريع الإروائية، وبعد فتح باب الكهريز الثاني ينساب الماء أيضاً بالطريقة نفسها التي دخل بها إلى الحوض ليخرج من الحوض ويتصرف إلى نهر دجلة الذي لا يبعد عن البركة سوى عشرات الأمتار إلى الغرب، لكون حوض نهر دجلة هو أقل مستوى من مستوى الحوض الحجري الدائري داخل البركة.
وكانت مادة البناء التي بني بها الكهريز الثاني الغربي هي الطابوق الفرشي
ص: 469
والجص والنورة وسُقفَ بالطابوق على شكل عقد مدبب أيضاً كما هو حال الكهريز الشرقي الأول.
لقد سقطت الكثير من أفاريز الحجر التي غلفت بها جدران الحوض الدائري (صورة - 3) مما أدى ذلك إلى تعرية جدران الحوض وظهور الطابوق وتشويه منظرها وتطلب القيام بقلع الحجر المتبقي القديم، لأنه هو الآخر قد خلع من مكانه وآل إلى السقوط، كذلك تطلب القيام بقلع مادة (المونة) السمنت الذي استخدم لتثبيت الحجر، واستمر العمل إلى أسابيع عديدة لصعوبة قلع مادة الحجر المونة، بعدها بوشر العمل بإعادة تغليف الحوض بالحجر من جديد ووضع سيم شائك (فروم سیم) خلف الحجر لزيادة قوة تثبيته، وبلغت كمية السيم الشائك المستخدم 420م2 ووضعت مادة السمنت (المونة) بكمية بلغت 10 أطنان مخلوطة بمادة الرمل.
أما كمية الحجر المستخدم بإعادة تغليف الحوض بلغت 420م2 ذات قياسات وأطوال مختلفة أما عرضها فبلغت 10 سم.
لقد تم تنظيف الحجر القديم الصالح للعمل بعد أن تم قلعه وبلغت كميته 220م2 كان بحالة سليمة وجيدة تم تغليف أسفل الحوض بارتفاع 1 متر به وبلغت المساحة المغلفة بالحجر القديم 220 م 2 . أما الجزء الأعلى من الحوض المتبقي بارتفاع 1/10 وطول 200 متر فتم شراء 200م2 من مادة الحجر الا أنه بنفس قياسات ومواصفات الحجز القديم وتم تغليف الجزء الأعلى للحوض وبذلك بلغ مجموع ما تم. تغليفه 420 م (صورة4).
2 - الواجهة الجنوبية الغربية
تقع هذه الواجهة بين المدخل الجنوبي والمدخل الغربي للبركة تألفت من مجموعة من الأواوين والخلوات بلغت ثمانية أواوين و ثمانية خلوات تطل على الحوض الحجري الدائري للبركة، ويفصلها عنه ممر عريض يحيط بالحوض. الدائري، ويأخذ
ص: 470
شكل الحوض بلغ عرضه 7 أمتار بلطت أرضيته بالطابوق الفرشي قياس 50×50×7 سم.
أما شكل الأواوين فهي عبارة عن بناء من الطابوق و الجص مؤلف من ثلاثة جدران مرتفعة ومفتوحة من الأمام على الحوض الدائري معقودة السقف بنصف قبة، يتوج هذه الأواوين عقود مدببة بلغ ارتفاع عقود ستة أواوين منها 5,60م وعرضها 2/85م وعمقها 2.4م.
أما الإيوانان الآخران المجاوران للمداخل فهما أكثر ارتفاعاً من الأواوين الأخرى، حيث بلغ ارتفاع كل منهما 8.25 م، وفي أركان الأواوين العليا عملت حنايا ركنية.
لقد استخدم قسم من هذه الأواوين والخلوات كمداخل تفضي إلى غرف وقاعات و ممرات بناية البركة، فقد فتحت المداخل في الأواوين والخلوات، وهي أقل ارتفاعاً من ارتفاع الأواوين والخلوات.
أما شكل الخلوات فهي عبارة عن بناء مؤلف من ثلاثة جدران أيضاً مفتوحة من الأمام على الحوض الدائري، عقدت سقوفها بأنصاف قباب صغيرة، ويتوج واجهات هذه الخلوات عقود مفصصة مكونة من خمسة فصوص، ومثل هذه العقود المفصصة وجدت تتوج حنايا قصر المعشوق، بلغت مقاساتها 85 عرضا وبلغ عمقها 80 سم، أما ارتفاع عقودها فبلغت 5٫10م تقع هذه الخلوات بين كل إيوانين ويفصلها عن الأواوين جدار بني بالطابوق والجص كما هو حال الخلوات بلغ عرضه 70 سم.
إن حالة الأواوين والخلوات أصابتها الرطوبة النازلة من السطوح ؛ نتيجة لعدم صيانة السطوح بمادة إنشائية عند صيانتها في السنوات السابقة سوى بطبقة بسيطة من الجص غير كافية لحمايتها من تسرب المياه إليها (صورة - 5 ) .
ص: 471
أدت هذه الرطوبة إلى سقوط أجزاء ومساحات كبيرة من مادة الجص ( البياض) التي كسيت بها الجدران والمتبقي من هذا البياض كانت الرطوبة واضحة عليه وأثرت به تاثيراً كبيراً، إضافة الي كتابات الذكرى التي كتبها الزائرون للموقع بمادة الفحم الأسود مما أدى إلى تشويهها وخرابها وإتلافها (صورة- 6).
توجب القيام بازالة وقلع ما تبقى من مادة الجص بحيث بلغت المساحة التي تم قلعها أكثر من 1000م 2 ، ثم أعيد بياضها بالجص والبورك لنفس المساحة التي تم قلعها أي 1000م2.
3- الواجهة الجنوبية الشرقية
تنحصر هذه الواجهة بين المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي للبركة، تألفت هذه الواجهة من مجموعة من الأواوين والخلوات بلغ عدد التي تم صيانتها لهذه الواجهة ثمانية أواوين وثمانية خلوات.
بنيت هذه الأواوين والخلوات بنفس الطريقة التي تم بها بناء أواوين وخلوات الواجهة الجنوبية الغربية التي سبق الكلام عنها، وأخذت مقاساتها بنفس مقاسات الأواوين والخلوات أيضاً عدا إيوانين اختلفت مقاساتهما، فالأول الذي يقع بجوار المدخل الجنوبي بلغ عرضه 3/15م وعمقه 2/45 م وارتفاعه 8/25م، والثاني يقع بجوار المدخل الشرقي بلغت مقاساته 4,35م عرضا و 2.45م عمقاً و 8/25م ارتفاعاً، كذلك بلغ عرض الجدران الفاصلة بين الأواوين والخلوات في هذه الجهة 70 سم.
كانت حالة مادة الجص (البياض) التي كسيت بها الجدران لهذه الواجهة ليست بأفضل من حالة جدران الواجهة الجنوبية الغربية، فقد أصابتها هي الاخرى الرطوبة النازلة من السطوح المكشوفة وأدت إلى قلع وسقوط أجزاء كبيرة من مادة الجص ، وشوهتها كذلك كتابات الذكرى بمادة الفحم الأسود، مما تطلب أيضاً قلعها
ص: 472
بالكامل، وتقدر المساحة المقلوعة أكثر من 1000 م2 ، وأعيد بياضها بالجص والبورك 2 النفس المساحة التي قلعت وبذلك يكون مجموع ما تم قلعه للجهتين الغربية والشرقية 2000م2 ، وما تم اعادة بياضه 2000م2 (صورة -7).
4 - مداخل البركة
للبركة أربعة مداخل رئيسة في الاتجاهات الأربعة الرئيسة، تألفت أشكالها من سلّم هابط معقود بعقد برميلي بالطابوق والجص ، يفضي في نهايته إلى قاعة ركبيرة يتقدمها إيوان كبير وواسع ومفتوح على الحوض الدائري زينت جدرانه وبارتقاع متر واحد بالزخارف الجصية النباتية من طراز سامراء الأول (صورة 8).
إن المداخل الرئيسة للبركة حدثت فيها شروخ وشقوق في سقوفها وجدرانها . وواجهاتها نتيجة بناء المداخل وجدرانها على الأسس القديمة الأصلية بارتفاعات عالية بلغ البعض منها 13 متراً (صورة - 9)
إن الأسس القديمة لم تتحمل الثقل الناجم من ارتفاع الجدران ولم تعمل لها عند بنائها الحماية الكافية والتقوية والتحصين، مما أدى ذلك إلى حدوث دفع في الجدران القديمة إلى خارج مستوياتها من الأسفل وبشكل واضح نتج عنه الشقوق والشروخ في البناء.
وهناك عامل آخر لإحداث الشروخ والشقوق في جدران المداخل؛ إذ لم تبن الجدران بطريقة الحل والشد لتربط مع بعضها البعض وتتماسك وتكون كتلة واحدة وهذا ما أدى إلى حدوث دفع بالجدران والى كل الاتجاهات حسب طريقة اتجاه بنائها. أضف إلى ذلك أن أحد هذه البوابات، وهي الجنوبية، لم تبن جدرانها بصورة مستقيمة، ويلاحظ على جدرانها ميلان واضح إلى الخارج نتج عنه دفع إلى الخارج وحدوث شرخ في سقف الإيوان الذي يتقدم المدخل من بدايته إلى نهايته، وحدث شقّ في الواجهة المطلة على الحوض، ولم تعمل لهذا المدخل صيانة لهذا العام؛ لأن
ص: 473
المبالغ المرصودة للصيانة لم تكف إلا لصيانة الأواوين والخلوات، ويحتاج المدخل إلى أن يهدم ويعاد بناؤه أو ان تربط الشقوق بطريقة (الخياط) بالحديد لتثبيت دفعها إلى الخارج وإيقافه.
5 - سقوف الواجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية
تركت سقوف الأواوين والخلوات والتي بنيت بشكل أنصاف قباب بدون تسوية أو غطاء لسطوحها تحميها من مياه الأمطار والتخريب سوى من طبقة خفيفة من الجص ، ولذا لاحظنا ان الرطوبة قد تسربت إلى سقوفها وجدرانها وبياضها وأدت إلى قلعها وتشويهها كما ذكرنا (صورة - 10).
وجدت البعثة ان الجدران الخلفية للسطوح تنخفض بمقدار 2،75 م عن جدران السطوح الأمامية المطلة على الحوض الدائري (صورة – 11)، لذا توجب أن ترفع الجدران الخلفية لتكون بمستوى الجدران الأمامية بالطابوق والجص (صورة -12)، وكانت كمية الطابوق الذي استخدم لرفع الجدران (35 ألف طابوقة) وبعد أن تساوت ارتفاعات الجدران الأمامية والخلفية بدات عملية ملئ المسافة المحصورة بين الجدران بمواد انشائية لغرض تسوية سطوح الأواوين والخلوات من أجل حمايتها من مياه الأمطار والتخريب فاستخدمت لذلك مادة الثرمستون والجص ( صورة -13) . وبلغت كمية الثرمستون المستخدم في تغطية السقوف 7800 ثرمستونة. اما المساحة التي تم ملؤها بمادة الثرمستون والجص بلغت 81 م طولا و 3/50م عرضا و 2،75م ارتفاعاً أي ان مجموع المساحة كانت 780م3 .
ان استخدامنا لمادة الطابوق والثرمستون في البناء لكون صيانة أبنية البركة التي عملت في السنوات السابقة كانت بمادة الطابوق والثرمستون
وبعد ذلك تم تسوية السطوح وتسييعها فوق الثرمستون بمادة الجص وتسليط
ص: 474
انحدارها إلى الخارج من الخلف كما تم وضع مادة الزفت فوق طبقة الجص (صورة- 14) لغرض منع سريان المياه إلى سقوف وجدران الأواوين والخلوات. وأخيراً تم وضع طبقة ثانية من الجص فوق الزفت لضمان عدم تكسر مادة الزفت بالبرودة والحرارة والحفاظ عليها ووضع مرازيب من الخلف لتصريف المياه.
6 - سلم المدخل الجنوبي
للبركة نوعان من السلالم، فالنوع الأول عبارة عن شق في الأرض يبلغ طوله 3 متر وعرضه 2,20م ، عمل له سلم هابط من الطابوق الفرشي وتم بناء جدران على جانبي الشقّ بارتفاع حوالي 4 أمتار، وسقفت بعقد مدبب فأصبحت على شكل أقبية، واستخدم هذا النوع من السلالم لنزول الناس إلى داخل البركة والخروج منها (صورة- 15).
والنوع الثاني عبارة عن شقّ حفر في الأرض أيضاً يبدأ من وجه الأرض وينزل إلى أسفل البركة بشكل منحدر (رمب) بلغ طول كل منها 32.50م وعرضها 1,50 م يقع هذا النوع من السلالم على يمين ويسار المداخل والسلالم الرئيسة للبركة الشمالية والشرقية والغربية، أما المدخل الجنوبي فله سلّم واحد من هذا النوع يقع إلى اليسار من السلم الهابط، وبذلك يكون مجموع السلالم المنحدرة سبعة سلالم (صورة -16).
تم بناء جدران لها على جانبي الشق بارتفاع حوالي (4 أمتار)، وسقفت بعقد مدبب أيضاً فأصبحت على شكل قبو، ويغلب على الظن ان هذا النوع من السلالم المنحدرة استخدم لنزول العربات والخيول التي كانت تنقل المواد التي يحتاجها الخليفة وحاشيته وضيوفه داخل البركة.
تعرض سلم المدخل الجنوبي (صورة - 17) إلى التخريب والحفر وعاد غير صالح للاستعمال لكثرة نزول وصعود الزائرين للموقع، مما توجب قلع الطابوق
ص: 475
القديم المخرب وإبداله بطابوق فرشي جديد وبنفس القياسات السابقة لتسوية سلالمه وإصلاحها.
كانت عدد الدرجات للسلم (54) درجة) ، كل درجة منها احتوت على (8) طابوقات فرشية، وبذلك يكون مجموع الطابوق المستخدم للسلم (432 طابوقة) فرشي جديد.
الأنقاض
وجدت البعثة أن هناك أنقاضاً وأزبالاً متراكمة من أعمال الصيانة السابقة تركت في غرف وقاعات البركة، ومنها أزبال وأوساخ تركها الزائرون من بقايا طعام ومحروقات الخشب، إضافة إلى ما تم استخراجه وما تخلف من أنقاض لأعمال الصيانة لهذا الموسم، ومنها مادة المونة من السمنت التي قلعت من حوض الحجر الدائري وأنقاض الجص المقلوع من جدران الأواوين والخلوات، وبلغ مجمل كميات الأنقاض حوالي 350م3 ، وقد قمنا بجمعها بواسطة العربات اليدوية في إحدى قاعات البركة بعدها تم إخراجها بواسطة محالة حديدية إلى الخارج لرميها خارج بناية البركة، بعدها تم نقلها بواسطة إحدى الدنابر ورميها بعيداً عن البركة (صورة- 18).
ص: 476
معوقات العمل
أ- نقل المواد الإنشائية
إن الاشتغال في أرض مكشوفة تصلها الآليات والعربات يكون العمل فيه أسهل بكثير من الاشتغال في مكان مرتفع أو منخفض ، فأرض موقع البركة تنخفض عن مستوى أرض قصر الخلافة بثلاثة عشر متراً، كما إن القاعات والغرف والممرات التي تركت مكشوفة غير مسقفة كانت حاجزاً يفصل المكان الذي تمت صيانته عن مستوى أرض قصر الخلافة، فكانت المواد الإنشائية من طابوق وثرمستون وجص وحجر ورمل وحتى الماء ترمى خارج مكان العمل بمسافة لاتقل عن (25-50م)، تنقل بعدها بالعربات اليدوية أو في الأيدي بالقرب من أحد الأواوين، ليتم تنزيلها بواسطة المحالة الحديدية إلى أسفل البركة، ثم تنقل وتوزع مرة أخرى على أماكن العمل والصيانة بواسطة العربات اليدوية أيضاً، وهذا تطلب جهداً ووقتاً طويلاً.
ب - الصقالة الحديدية
المعروف عن بناء البركة انها عبارة عن أواوين وخلوات داخلة عن مستوى الواجهات، أما الواجهات فهي الأخری اختلفت مستوياتها البنائية وذات ارتفاعات وعقود مختلفة أي انها لم تكن بمستوى واحد فكان العمل يوميا يجري بنصب الصقالات الحديدية على مجموعة من الأواوين أو الخلوات، ثم يعاد فتحها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لهذه الأواوين ويعاد نصبها على أواوين غيرها، ومنها ما تضاف إليها بواري أخرى لغرض رفعها أكثر ، أو تسحب منها بواري لغرض خفضها، وهذا ماكان يتطلب زيادة في عدد العمال وياخذ وقتاً وجهداً اضافياً (صورة -19).
ص: 477
الاقتراحات
1 - تشديد المراقبة على الزائرين للموقع ومرافقتهم عند النزول إلى داخل البركة، ومنعهم من العبث واشعال النار داخل الغرف وقاعات البركة، ومنعهم من الكتابة بمادة الفحم أو أية مادة أخرى على الجدران التي تم صيانتها وبياضها ونضارتها والمحافظة على الزخارف من التشويه والتخريب.
2- غلق جميع المنافذ التي يستخدمها الزائرون للنزول إلى داخل البركة، إذ إن البعض من الزائرين يمكن أن ينزل أو يتسلق من الجدران الخلفية للبركة من غير الدخول من المدخل الرئيس، وذلك بإحاطة البركة بسيم شائك (B.R.C) وغلق جميع المداخل الرئيسة والإبقاء على مدخل واحد، وهو المدخل الجنوبي، ووضع باب محكم من الحديد له لا يفتح الا في وقت الزيارة.
ص: 478
الصورة
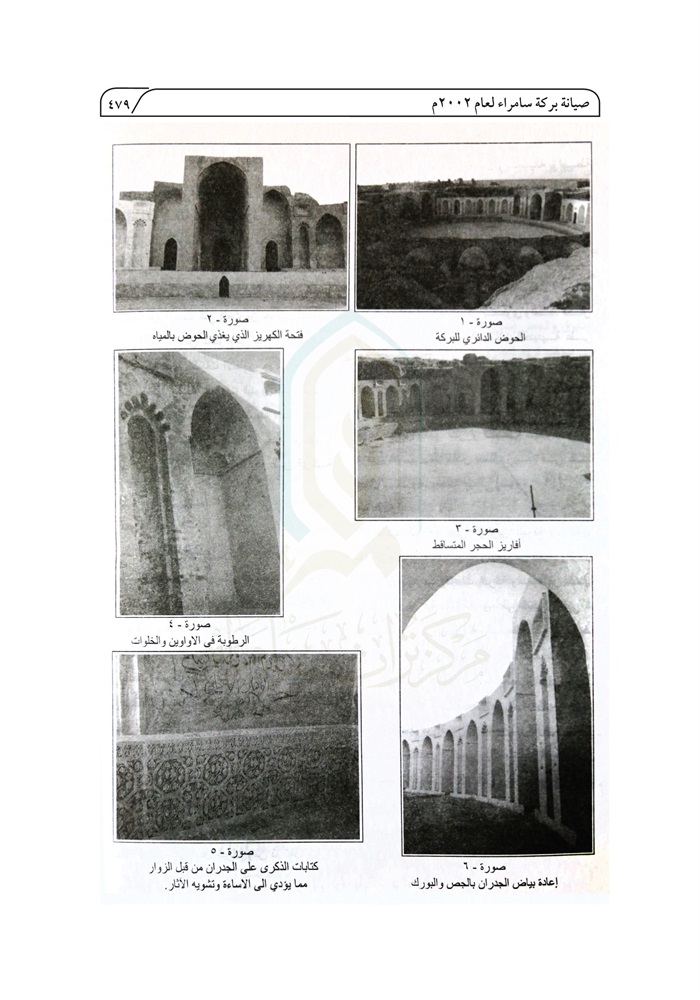
ص: 479
الصورة
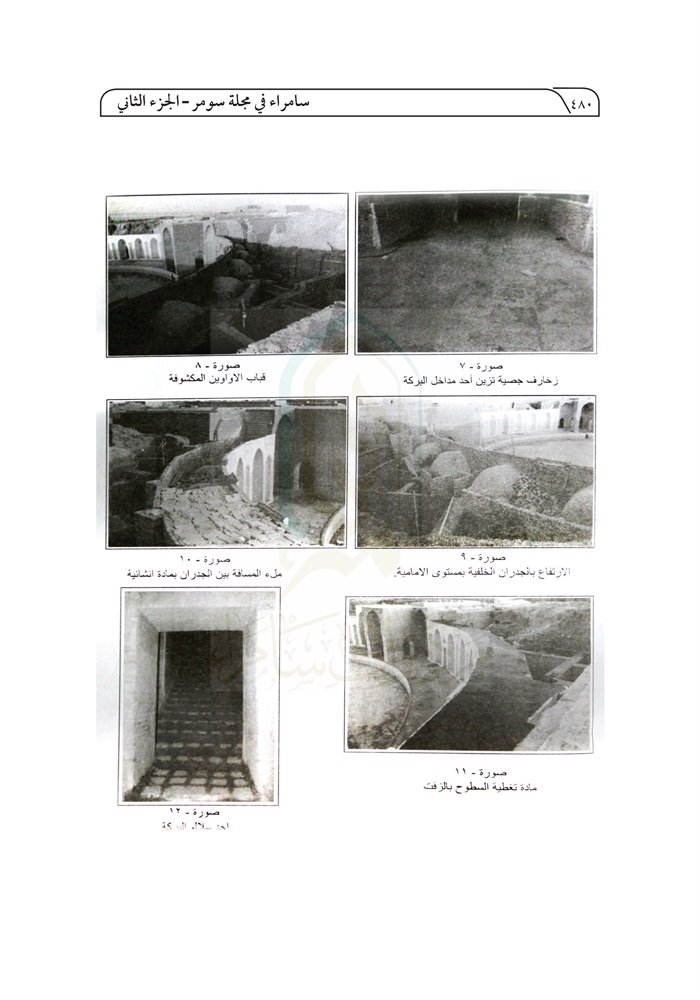
ص: 480
الصورة
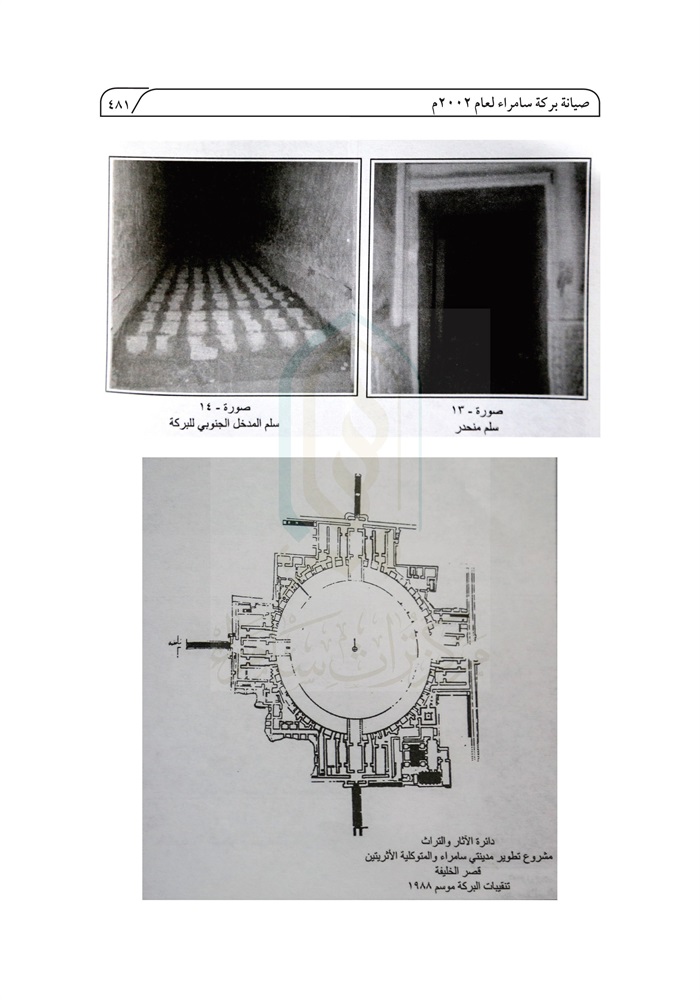
ص: 481
ص: 482
المجلد الحادي والخمسون سنة 2005 – 2006م
أ.د. ناهض عبد الرزاق دفتر
قسم الآثار - كلية الآداب
- جامعة بغداد
تعتبر القبة الصليبية في سامراء من أقدم المشاهد والترب في العالم الإسلامي أجمع، لأنه لم يبق من القباب والترب والمشاهد التي ذكرتها كتب التاريخ والتراجم شيء من التي شيدت قبل هذه القبة، بسبب عوامل التخريب والهدم البشري أو التأثيرات الطبيعية كالأمطار والرياح التي تسببت في التعرية، ومثل تلك الأبنية لها مكانة خاصة عند المسلمين لاسيما تلك التي ضمت رفات رجال دين أو فقهاء أو علماء اشتهروا بعلمهم أو أسسوا مذاهب، مما دفع بالموالين والأتباع إلى العناية بالأبنية المشيدة على قبورهم (1) . ولأهمية القبة الصليبية في سامراء فقد تشكلت هيئة فنية للتنقيب والصيانة فيها، وذلك عام 1974(2).
وقد استمر العمل فيها لمدة تقارب الأربعة أشهر اشتملت على أعمال التحري والتنقيب، وقد أكملت صيانتها في المواسم اللاحقة، حيث تطلب العمل الكثير من الاستعدادات وتوفير المواد اللازمة لبدء العمل، وذلك في حزيران 1974 شكل (1، 2).
ص: 483
الموقع والتسمية:
تقع القبة الصليبية إلى جنوب قصر المعشوق، غير بعيدة عنه، على تل يشرف على نهر دجلة من الجانب الغربي. أما عن تسميتها ، فقد ذكرت عدة احتمالات لها، فقد ذكر الأستاذ أحمد سوسة أنها سميت كذلك لأنها كانت موضعاً لصلب الخارجين عن الخلافة العباسية (1).
ويذكر الباحث الآثاري هير تسفيلد أن هذا الموضع كان مدفناً لامرأة عربية أصلها من قبيلة صليب، وكانت زوجة لأحد الخلفاء (2).
ويذكر الباحث عادل نجم ان الاسم أطلق حديثاً خلال فترة العصور المظلمة من تأريخ العراق، لأن هذا المكان اتخذ في حالات انعدام الأمن في البلاد مكمناً لقطاع الطرق واللصوص الذين كانوا يسلبون المارة، فيقال لهم في اللهجة العامية(الصلیبیة)، جمع سالب أو سلاب فأخذت الاسم من هذه الحالة، وعرفت بقبة الصليبية، ثم حرف السين إلى صاد فأصبحت الصليبية(3).
وبالنسبة للاعتقاد الأول الذي أورده الباحث أحمد سوسة بأنه موضع لصلب الخارجين على الخلافة العباسية ، فليس هناك ما يؤيد هذا الاعتقاد، إذ إن من المعروف أن صلب الخارجين على الخلافة كان يتم على باب العامة من قصر الخليفة، حيث تم هناك صلب الأفشين القائد التركي سنة 226 هجرية / 840 ميلادية (4)، كذلك نصب رأس الحسين بن يحيى بن عمر أمام هذه الباب بعد أن قتل بالقرب من الكوفة سنة 250 هجرية. أما الرأي الثاني الذي أورده هير تسفيلد، فلا نعرف زوجة لخليفة
ص: 484
عباسي من قبيلة صليب؛ لذلك يكون رأي الباحث عادل نجم عبو هو الأقرب للاعتقاد بهذه التسمية.
الغرض من بناء القبة الصليبية:
ذُكر ان الغرض من بناء القبة الصليبية أنها كانت برجاً لمراقبة مدخل الجسر الذي كان يربط ضفتي النهر وينتهي عند موضع القبة أو بالقرب منه(1)، في حين يذكر هيرتسفيلد أنه كشف أثناء تنقيباته الآثارية في كانون الأول من العام 1911 ، ثلاثة قبور تحت أرضية القبة أرجعها إلى ثلاثة من الخلفاء العباسيين وهم الخليفة المنتصر المتوفى سنة 228 هجرية والخليفة المعتز المتوفى سنة 255 هجرية، والخليفة المهدي المتوفى سنة 256 هجرية. وقد ذكر الطبري ان الخليفة المنتصر توفي سنة 248 هجرية، وكانت وفاته في سامراء وصلى عليه أحمد بن محمد المعتصم، ويعتبر المنتصر أول خليفة عباسي عرف قبره بعد أن طلبت أمه إظهار قبره، في مقبرة قرب قصر الصوامع (2)، ولكن لا يعرف بالضبط أين يقع هذا القصر.
كما ودفن الخليفة المعتز سنة 255 هجرية مع الخليفة المنتصر (3)، وفي السنة اللاحقة 256 هجرية قتل الخليفة المهتدي ودفن في مقبرة المنتصر (4). لكن يبقى السؤال، أين تقع هذه المقبرة؟ هذا ما لا نعرفه سوى أنها خارج القصور التي كان معظمها إلى الجهة الشرقية من نهر دجلة، في حين يكون موقع القبة الصليبية غرب نهر دجلة وأقرب قصر إليها هو قصر المعشوق الذي بناه الخليفة المعتمد على الله 256 - 27 هجري / 870 - 192 ميلادي.
وقد يكون بناء القبة الصليبية بنفس الوقت الذي تم فيه تشييد قصر المعشوق
ص: 485
زمن الخليفة العباسي المعتمد على الله للأسباب التالية :
1 - قرب القبة من قصر المعشوق إلى الجنوب منه
2 - استعمال مادة بنائية واحدة في المعشوق، وتقع والقبة، وهي الآجر الجصي والذي لا نجده في أبنية سامراء الأخرى، ويبلغ قياس الآجر الجصي 32×32×9سم في القصر والقبة.
3-من المعروف ان الخليفة المعتمد على الله كان قد توفي بمدينة السلام سنة 279 هجرية، لكنه نقل إلى سامراء ودفن فيها (1) ، مما يدل على وجود بناء معد مسبقاً لدفنه، وقد تكون الصليبية القريبة من قصره.
4 - عند إجراء التنقيبات في قبة الصليبية عثرت البعثة على تكسرات في أرضية القبة ودفن غير منتظم لعدد من الأطفال كما تناثرت القبور بالقرب منها مما يؤكد أن ليس لهذا المدفن قدسية؛ لحالات الدفن المبعثر هناك.
5- إنّ عمل مظلات على قبور بعض الأشخاص كان منذ القرن الأول الهجري، ففي سنة 68 هجرية توفى عبد الله بن عباس بالطائف وصلى عليه محمد بن الحنفية ودفن بالطائف بمسجدها الجامع وضرب عليه فسطاط، ولعل هذه أولى الظواهر في عمل السقائف على قبور الصالحين (2).
تخطيط القبة الصليبية وأعمال البعثة التنقيبية:
تتكون القبة من غرفة مربعة من الداخل تزينها المقرنصات في الزوايا الأربع حولتها إلى شكل مثمن حمل القبة فوق الغرفة المربعة من الداخل والمثمنة من الخارج يدور حولها رواق يبلغ عرضه 20, 6م ، يقوم بعده السور المثمن الخارجي الذي يبلغ سمك جدرانه 1/20 م ، وطول كل ضلع من الداخل 6،30م وطولها من الخارج
ص: 486
7،70 ،م، وللقبة أربعة مداخل رئيسة تقابل الاتجاهات الأربعة تقريباً.
وقد كشفت التنقيبات الأثرية جملة مرافق تصل بمركز القبة بشكل متصالب، وتتكون من أربع وحدات في كل وحدة بنائية مغسل يشبه الحمام بلطت أرضية الحمام بمادة القار، وفي كل غرفة حوض لجمع الماء بعد الاغتسال.
أما بقية المعالم البنائية فهي عبارة عن غرف مستطيلة الشكل ذات سقوف نصف برميلية كأنها قبور أعدت لدفن الموتى.
كما كشفت التنقيبات الأثرية عن بعض الفوارق فيما ذهب إليه كل من هير تسفيلد وكريزويل. ومن ناحية أخرى أظهرت التنقيبات ان جدران البناء كانت مطلية بكساء جصي من الداخل والخارج، ولازال قسم من هذا الكساء باقياً حتى وقت كتابة هذا البحث (شكل - 4 ) .
وقامت بعثة التنقيب والصيانة بإعادة بناء القبة المتهدمة، (شكل 5، 6 ، 7) حيث أعيدت استناداً إلى الأجزاء القليلة المتبقية منها، وظهرت القبة بشكل نصف كروي مدبب قليلاً وليس للقبة رقبة. أما سقف الرواق بين الجدران التي حملت القبة والجدران الخارجية فكان على شكل مقبب نصف برميلي، وقد استخدم الأجر الجصي والجص في بناء القبة وسقف الرواق.
أما العقود المستخدمة في القبة الصليبية فهي العقود المدببة في جميع الفتحات وأبواب هذه القبة. وهذا النوع من العقود استخدم في قصر المعشوق، وفي معظم أبنية سامراء.
مما تقدم نلمس أهمية القبة الصليبية في سامراء، وتعتبر من المشاهد المعمارية الشاخصة في هذه المدينة العربية الخالدة، والتي تعتبر بحق نموذجاً مهماً للمدينة العربية (شكل 8، 9).
ص: 487
المصادر:
1 - تقرير هيئة التنقيب والصيانة التي عملت في قبة الصليبية.
2- سلمان، عيسى؛ المشاهد والترب، حضارة العراق، ج 9، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1985 .
3 - نجم عبو، عادل؛ القباب العباسية في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى جامعة بغداد-قسم الآثار ، 1967.
4- سوسة، أحمد؛ ري سامراء في عهد الخلافة العباسية، جزءان، بغداد 1948- 1949.
5- الطبري: تاريخ الرسل والملوك، القاهرة، 1939.
6- ابن الأثير الكامل في التاريخ، ج 7، بيروت، 1967
7 - المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر، طبعة باريس، 1861
8- اليعقوبي: تاريخ / اليعقوبي، مطبعة دار صادر، بیروت، 01960
9- Creswell.K.A.C ,Early Muslim architecture:Umayyad Abbasids .oxford 1932-40
10- Herzfeld.E samarra Aufnahment und unt .ersuchunren zur Islamischen Archaologie ، berlin 1907
11 - الآثار القديمة في العراق: سامراء، بغداد، 1940.
12 - الأعظمي، خالد خليل حمودي: دليل سامراء، المؤسسة العامة للآثار والتراث، بغداد، 1985.
ص: 488
الصورة
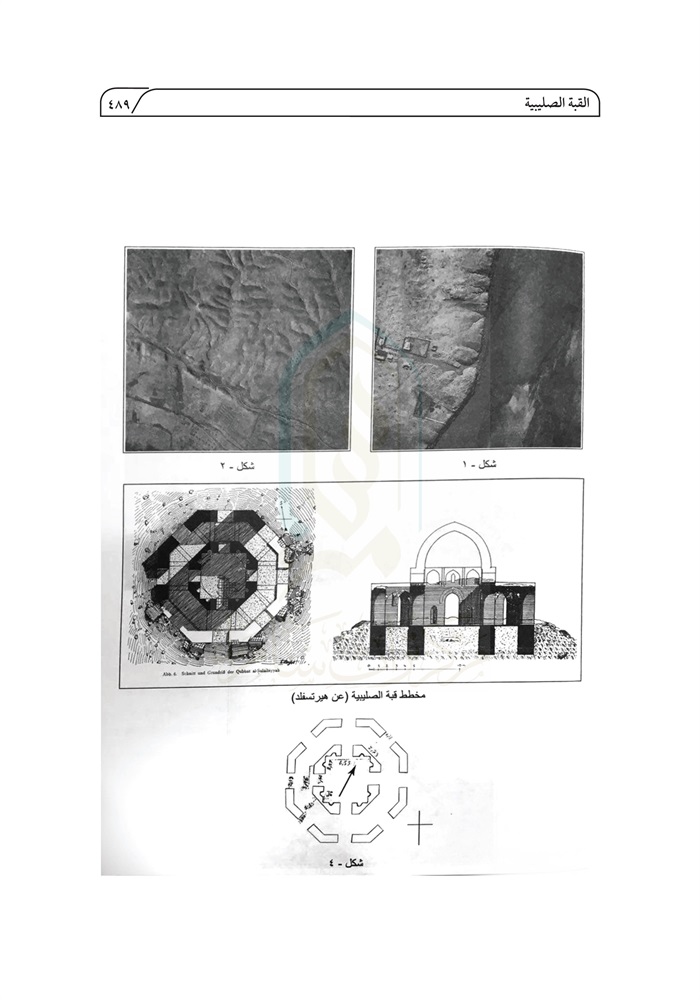
ص: 489
الصورة
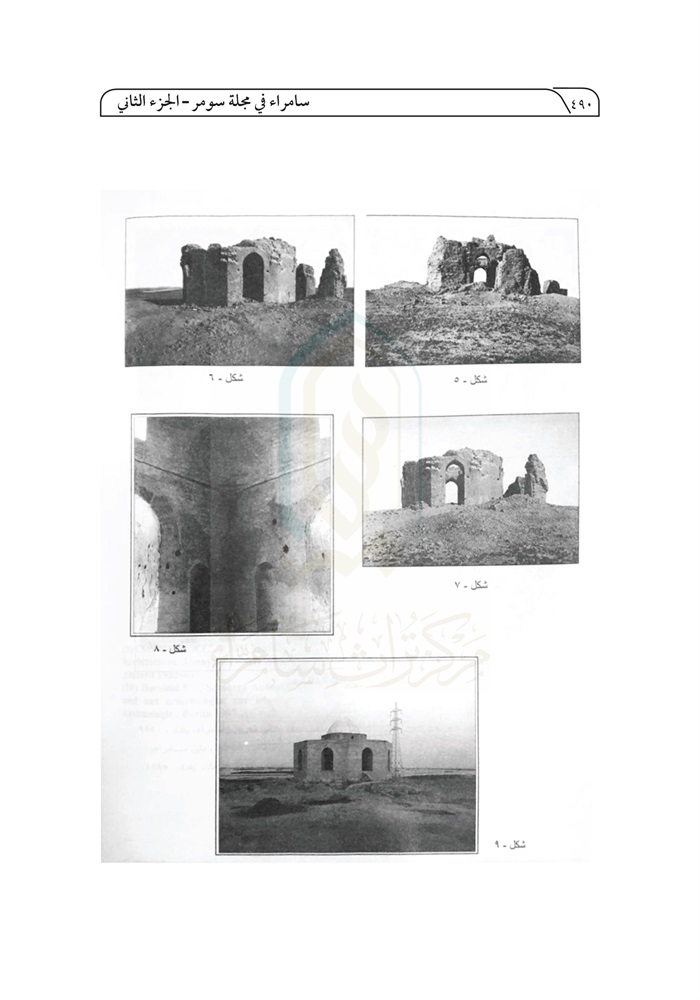
ص: 490
المجلد السابع والخمسون سنة 2012م
د. هشام عبد الستار حلمي
حظيت العمارة العباسية في سامراء باهتمام عدد من الباحثين(1) والمتخصصين وقد غطت أعمالهم الأثرية وأبحاثهم العلمية، الأصول العمارية العباسية في سامراء (2).
حيث بدأ اهتمام العلماء بأطلال مدينة سامراء منذ العقد الأول من القرن العشرين، فقد قام المهندس الفرنسي (هنري فيوله) لأول مرة ببعض التقنيات الاستكشافية في دار الخليفة، ثم أعقبه العالم الألماني هرتسفيلد على رأس بعثة علمية في عام (1912 - 1913م)، وأثبت أن المدينة كانت مشيدة على مستوطن يعود تاريخه إلى عصور ما قبل التاريخ (العصر الحجري الحديث)، كما شملت تنقيباته دار الخليفة وقصر بلكوارا والمسجد الجامع.
وبدأت أعمال التنقيب لمديرية الآثار العامة عام (1936م)، واستمرت أربعة مواسم حتى انتهاء عام (1939م) ، ولم تنقطع أعمال التحري والتنقيب والصيانة التي تقوم بها المديرية حتى السنوات القليلة الماضية.
بدأ الخليفة المعتصم في تشييدها (3)، وبنى جامعها الكبير سنة (221ه_
ص: 491
839م) ، وحينما جاء المتوكل إلى الخلافة (232 ه_ - 847م) (1)، هدمه وبني مكانه جامعاً أكبر منه في سنة (234 ه_ - 849م)، وما يزال هذا الجامع يعد من أهم الجوامع الأثرية الباقية التي شيدت في العصور الإسلامية المختلفة.
تدل الصور الجوية لهذا الجامع على وجود آثار لبقايا سور عظيم مبني باللبن، مستطيل الشكل ( 607× 506م) ، كان يحيط به من جميع جهاته ويضم المئذنة (الملوية) ضمن حدوده (2)، أما السور الثاني (440× 376م)، جدرانه مبنية بالآجر يدعمها 68 برجاً نصف اسطواني، أربعة منها كبيرة في الأركان، أما السور الداخلي فهو مستطيل الشكل مبني بالآجر (240 × 156م) مدعم من الخارج ب_ (44) برجاً بهيئة نصف اسطوانية (شكل 1).
ويستدل من الحفريات التي أجريت في الجامع أن طول جدار القبلة من الداخل يبلغ (150م) (3)، وعمق بيت الصلاة فيه (62م) ، الذي كان يضم تسعة أروقة تحدّها تسعة صفوف من الأكتفاف (4) المثمنة ذوات قواعد مربعة توازي جدار القبلة في كل منها أربعة وعشرون كتفاً، تقسّم الأروقة إلى خمس وعشرين بلاطة، ويحيط بصحن الجامع الفسيح مجنبات في جهاته الثلاث، ففي كل من المجنبتين الشرقية والغربية أربعة أروقة تحدها أربعة صفوف من الأكتاف باتجاه القبلة في كل منها اثنان وعشرون كتفاً، وفي مؤخرته ثلاثة أروقة في كل منها أربعة وعشرون كتفاً على نظام أكتاف بيت
ص: 492
الصلاة، وبهذا يكون مجموع الأكتاف الداخلية في الجامع (464) كتفاً (1).
ويعد استعمال الأكتاف في هذه الفترة من الظواهر العمارية البارزة في العمارة العباسية، غير أن الأعمدة في أركانها لاتقوم بالدور البنائي المعتاد في رفع أثقال البناء القائمة فوقها، وهي تمثل في مثل هذه الروافع بدعاً عمارية ذات مظهر تزييني (شكل 2).
وقد وصف هرتسفيلد بعض الأعمدة بعد تفحصه لبقايا الأكتاف بأنها تمثل أسلوب المعمار اليوناني (2)، وقال عنها انها تشمل تسعة أنواع مختلفة من المرمر، ولم أجد في متحف سامراء سوى ثلاث اسطوانات وهي أجزاء من الأعمدة، اثنتان متشابهتان مثمنتان، طول الأولى (2,30م) وقطر قاعدتها (44 سم ) ، تميل جوانبها نحو الداخل كلما ارتفعت إلى الأعلى، والعمود الثاني مثمن الشكل أيضاً طوله (2,14م) وقطره (30 سم)، يحتوي على ثقوب جانبية متجاورة كان الغرض منها احاطتها بحلقات معدنية على الأرجح ، أما الاسطوانة الثالثة فطولها (2/41م) وقطرها من النهايتين (27سم)، وتحمل المواصفات السابقة نفسها.
ولهذا فقد حاولت في هذا البحث تقصّي المبادئ الرئيسة لدراسة الأعمدة والأكتاف في عمارة سامراء - ورأيت من واجبي أن أوضح نظمها وأسجل نتائج أبحاثي عن أصولها، لوضع تقييم على إشراقات تراثنا التاريخي بعيداً عن الموضوعية ومتطلبات البحث العلمي، والتي ساعدتنا على بعض المكتشفات الآثارية الجديدة على إعادة بعض الآراء وتقويمها تقويماً يناسب تاريخنا المتبقي، الأمر الذي أوصلني إلى الكشف عن نتائج مهمة منها المبادىء الهندسية التي وضعت من قبل المهندسين
ص: 493
العراقيين، وإرجاع تلك المبادىء إلى الأصول الهندسية العراقية التي كانت متبعة في عمارة العراق.
واذا حاولنا معرفة صفات هذه الأعمدة، لابد لنا من الاستعانة بالنصوص التاريخية، وما ذكره المستشرقون عنها للوصول إلى شكلها وصفاتها وأصل استخداماتها :-
1 - يقول اليعقوبي(1) ان المعتصم هو الذي (كتب في إشخاص الفَعَلة والبنائين وأهل المهن من الحدادين والنجارين وسائر الصناعات، وفي حمل الساج وسائر الخشب والجذوع من البصرة وما والاها من بغداد وسائر السواد، ومن أنطاكية وسائر سواحل الشام، وفي حمل عملة الرخام وفرش الرخام، فأصبحت باللاذقية وغيرها دور صناعة الرخام).
و مما يؤكد صحة هذه الرواية، أن الأعمدة التي وصفها المستشرقون واعتمدها الباحثون المحدثون (2)، كانت تعود على الأرجح إلى فترة بناء الجامع زمن المعتصم (221 ه_ - 836م) عندما كان موقعه في النهاية الشمالية للسوق الرئيسة على الشارع الذي يعرف بالسريجة، غير ان المتوكل (232ه_ - 846م)، شيّد جامعاً كبيراً عند أول الحير، ولاشك في انه لم يترسم خطى المعتصم في اختيار العناصر العمارية في بناء الجامع.
2 - يقول كل من هرتسفيلد وكريسول(3): إن الأعمدة المرمرية ثلاث قطع موصولة فوق بعضها بواسطة الرصاص والسفافيد المعدنية، طول كل اسطوانة منها أكثر من مترين، أما أطوال الأعمدة الباقية حالياً، فهي تتراوح بين (2014م)، (203م) بعضها اسطوانية الشكل والبعض الآخر مثمن (شكل3)، ومن غير المعقول
ص: 494
ان تستخدم مثل هذه الأنواع المختلفة والتي تفتقر إلى الانسجام لعدم تناسقها مع العناصر العمارية الأخرى في الجامع.
3 - وإذا جاز لنا الاقتناع برأي المستشرقين من أن أعمدة جامع سامراء الكبير مصنوعة من الرخام، غير اننا في الوقت نفسه نتساءل أين ذهب هذا العدد الضخم منها والذي يبلغ نحو (1772 عموداً). هل نقل إلى بغداد كما يقول ياقوت الحموي (1) بعد خراب سامراء عندما (استدبر أمرها جعلت تنقل وتحمل أنقاضها إلى بغداد يعمر بها)، وان العدد القليل الذي عثر عليه في الجامع منقولاً من جامع سامراء الأول أو من بعض قصورها في فترة متأخرة.
4 - والذي نراه أن الأعمدة المندمجة في نوافذ جدار القبلة والبالغ عددها (24) نافذة مبنية بالآجر ماهي الا نماذج مصغرة لأشكال أعمدة الأكتاف وأعمدة محراب الجامع على الأرجح، لأننا نشك في صحة أشكال الأعمدة الحالية للمحراب لعدم وجود معالم اصلية لها، وإن مديرية الآثار أعادت بناءها على نمط ما عثر عليه من أشكال لبقايا الأعمدة الرخامية في الجامع (2).
5 - ومما يسند رأينا ان أحمد بن طولون الذي عاش في سامراء في زمن المعتصم والمتوكل اللذين كانا يهتمان بالبناء والتعمير، نقل معه مثل هذه الظواهر العمارية عند بناء جامعه في مصر سنة (263 ه- - 876م باستثناء المئذنة، فالظاهرة العمارية الأولى تتمثل في شكل وطرز ومواد بناء الأعمدة والتي نقلها من جامع المتوكل، والثانية شكل الأكتاف المستطيلة نقلت من جامع أبي ،دلف، وكان الغرض من تصميمها (الأكتاف) رفع العقود إلى ارتفاع ثمانية أمتار ، وللسقوف نحو عشرة أمتار، بحيث يجعل الضوء والهواء يغمران بيت الصلاة (3). أما الظاهرة الثالثة فهي تتمثل في الأعمدة التي تحف
ص: 495
بالطاقات المعقودة بين العقود، لتتناسب مع أشكال ومواد بناء أعمدة الأكتاف.
والحقيقة أن المعمار السامرائي كان يعتمد أصول الهندسة السطحية في الاستعمالات التطبيقية التي ركزت على النسب الهندسية ، وقد سبقه في ذلك العراقيون القدماء، فكان العاملون في البناء مهندسين ميدانيين يطبقون في أبنيتهم ما لديهم من خبرات في علم الرياضيات والمثلثات، الذي ورثه كل من اليونانيين والساسانيين.
فالمعمار السامرائي في تصورنا رسم مخططات أبنيته قبل تنفيذها على الأرض، ففي جامع سامراء الكبير راعى الشكل المربع أساساً لاستخراج النسبة في احتساب ارتفاعات الأعمدة والأكتاف ثم ارتفاع السقوف التي تستند اليها، وأن الفنان العربي اعتمد على الشكل المربع أساساً لاحتساب مثل هذه الارتفاعات، حيث تكمن في المربع علاقة غير محدودة بين أضلاعه، منه يتولد المضلّع والدائرة والمثلث والمثمن الناتج من تقاطع مربعين، وقد اعتمده المعمار هنا في تصميم شكل الأكتاف في الجامع كخطوة للانتقال من شكل القاعدة المربعة إلى شكل أبدان الأكتاف المثمنة، ثم تمكنه من احتساب ارتفاع السقوف المرتكزة عليها بدون عقود.
فالنسب المستخدمة في جامع سامراء الكبير، وربما في الكثير من العمائر فيها، اعتمدت على النظرية البابلية في تحليل المثلثات التي تكون النسبة الثابتة أساساً لها(1) والخلاصة ان المعمار العربي المسلم أدرك قيمتها العملية في هذه الفترة، اذا اعتمد على النسب الثابتة لكل من المربع (القاعدة) والمثمن (الكتف) لإيجاد ارتفاع مناسب للسقف الذي يرتكز على هذه العناصر العمارية بشكل مستو وبدون عقود، والغرض من تجزئة الثقل وتوزيعه بمهارة، بواسطة الأكتاف للحصول على متانة مناسبة مع الإبقاء على رشاقة الهيكل الإنشائي، والاحتفاظ بسيطرة الفضاء سيطرة تامة على
ص: 496
عناصر وأقسام هذه التشكيلة الإنشائية، وقد أنكر كريسول(1) وغيره من المستشرقين فضل المعمار العربي في حل مشاكل البناء هندسياً وفنياً، الا أنهم اعترفوا في مواضع أخرى في بحوثهم باستخدام هذه النسب لاحتساب أطوال الأعمدة والأكتاف. وعللوا ذلك في أنها تمنح كلاً من التيجان والقواعد الجرسية ارتفاعين متناسبين مع أطوال الأعمدة والأكتاف التي تبلغ (9/50م).
أما الأكتاف فقد أشار إليها هرتسفليد (2) أنها مبينة في الطابوق والجص على قواعد مربعة طول كل جانب منها (2/07م) وارتفاعها عن الأرض (1م) ، يقوم عليها تركيب من كتف مثمن في أركانه أعمدة تزيينية حرة (غير مندمجة) ترتفع إلى علو (7/50م) ابتداء من نقطة ارتكازه على القاعدة، ليكون الارتفاع الاجمالي لكل من هذين العنصرين نحو (9/50م) بعد أن يضاف إليه كل من ارتفاع القاعدة (1م) وثخن الوسادة (1م) أيضاً.
بعد أن اطلعنا على النسب التي أوضحها كل من كريسول و هرتسفليد وغيرهما من العلماء الآثاريين العرب والأجانب، ما وصل إلينا من أمثلة عمارية إسلامية كثيرة، نستطيع القول إن باعثيها إلى الوجود معماريون و مهندسون بلغوا درجة كبيرة من اتقان الصنعة، وضربوا بسهم وافر في ميدان الخبرة والمهنة، وكانت لهم أهمية عظيمة في تنفيذ بناء العمائر، وقد أحجم المستشرقون عن إيراد أي ذكر لهم، هادفين من وراء ذلك، تجريد العرب من اي علم له مساس بالعمارة وأصولها وما يرتبط بها من علم الهندسة والرياضيات.
وقد ذكرت المصادر التاريخية العربية (3) بعضاً من المهندسين العرب الذين
ص: 497
باشروا تنفيذ المشاريع العمرانية ووضعوا تصميمات شاملة وتفصيلية، لإجراء العمائر معتمدة على المبادئ الهندسية والرياضية، لاستخراج الارتفاعات المطلوبة محسوبة على الورق قبل تنفيذها على الأرض، ومن المعروف أن الكثير من تخطيط المساجد والقصور وما تشتمله من مزايا هندسية وتفاصيل عمارية، يصعب على المعمار تنفيذها من غير رسم هندسي مسبق.
وبناءاً على ماتقدم فاننا نرى أن بناء مدينة سامراء وتخطيطها بضمنها جامعا سامراء الكبير وأبي دلف، خضعت لنظم هندسية وتصميمات مدروسة، يهمنا منها بوجه خاص الأكتاف المثمنة المرتكزة على القواعد المربعة التي تحمل السقوف مباشرة من غير عقود كما في جامع سامراء، أو الأكتاف المستطيلة التي تحمل عقوداً يستند إليها السقف كما في جامع أبي دلف لاستخراج ارتفاعها وفق نسب رياضية ثابتة، ولأجل تفسير هذه الناحية حسابياً يمكننا القول:
1- كان الهدف من استخدام الأكتاف المثمنة الشكل والمستندة إلى قواعد مربعة، التي يبلغ طول ضلعها (207م) في جامع سامراء هو لحل مشكلة التسقيف دون عقود والحصول على أكبر كفاءة من التكوينات العمارية ذات المردود الجمالي.
2 - ان قطر المثمن على الأرض يبلغ (2/25م)، واعتماداً على التخطيط الذي وضعه هرتسفليد للأكتاف (شكل 3) وبمقياس (100/1)، نرى أن قطره يساوي (2,25م) .
3 - عند تطبيق قانون (القطر × النسبة الثابتة) والنسبة الثابتة = 22 / 7 أو ما يعادل نحصل على 2/25 (قطر المثمن ) × 7/22 (النسبة الثابتة = 7,06م) ارتفاع العمود مع القاعدة والتاج ويساوي أيضاً ارتفاع الأكتاف عدا القاعدة والوسادة العليا، وقد حدد كريسول الارتفاع نفسه بالاعتماد على مخطط هرتسفليد.
ص: 498
4 - نضيف إلى الناتج ارتفاع كل من القاعدة (1م) والوسادة العليا (1م) أيضاً - تكون النتيجة (7/06 م) (ارتفاع الأكتاف + ( 2م) ارتفاع كل من القاعدة والوسادة 9,06م(1) ، وعند إضافة ثخن مادة الربط الجص (المونة) والبالغة (14سم ) لمجموع سافات بناء الأكتاف إلى النتائج أعلاه م، يكون الناتج (20م).
5 - تتطابق هذه النتيجة مع ما أوردناه ومع ما نفذه هرتسفليد في مخططه مع ما حدده کريسول من ارتفاعات لهذه العناصر العمارية.
يتبين مما سبق ان وراء مثل هذه الحسابات إمكانيات هندسية كبيرة، وراءها مهندسون حاذقون يضعون للأبنية تصميمات شاملة وتفصيلية كانت تنفذ أولاً على الورق أو الجلود أو القماش كما نفذها العراقيون القدماء على الطين منذ الألف الثالث ق.م (2)
جامع أبي دلف (3)
يقع الجامع في مدينة المتوكلية (4) (245ه_ - 860م)، التي بناها المتوكل على الله على الضفة الشرقية لنهر دجلة، يبعد عن مدينة سامراء الحالية نحو ( 20كم)،
ص: 499
وهو مستطيل الشكل (251/47×138/24) (1)، ويتكون من صحن مستطيل تحيط به من الجهات الأربع أروقة أوسعها رواق القبلة الذي يبلغ عمقه نحو (40م)، ويتكون من (17) بلاطة وستة أروقة تنتهي البلاطات من الداخل بأكتاف على شكل (T) وتحمل أقواساً باتجاه مواز لجدار القبلة، وتنتهي (12) من هذه البلاطات إلى جهة الصحن بأكتاف متشابه تعلوها عقود تؤلف الواجهة الجنوبية للصحن، أما الأروقة الجانبية المجنبتان (المجنبتان) فعمقها نحو (14م) ، وتطل على الصحن بتسع عشرة ،بائكة اما المؤخرة فتتكون من ثلاثة أروقة تطل على الصحن بثلاث عشرة بائكة ترتكز على أكتاف مشابهة للأكتاف المواجهة لها في الجهة الجنوبية (شكل 4).
فالأكتاف في بيت الصلاة التي بشكل T تبلغ مساحة قطرها (3,80 م× 1,6م) عدا الكتفين المتصلين بجدار السور الشرقي والغربي، فإنهما يبرزان عنه بمقدار (170م) ، أما الأكتاف التي تتكون من أربعة صفوف في كل صف ستة عشر كتفاً، مساحة قطاع كل منها (2/15م× 2/15م) والأكتاف في كل من المجنبتين الشرقية والغربية يبلغ عددها (36) كتفاً، مستطيلة الشكل مساحة قطاعها(4,20م×1,70م)، ا أكتاف المؤخرة (القسم الشمالي) فهي مربعة الشكل أيضاً، (شكل5)، وعند تدقيق نسبة الأبعاد لهذه الأكتاف نرى أنها تشترك بعرض واحد بالرغم من اختلاف اطوالها، وقد وضع المهندس في حسابه الاستفادة من هذا العرض لإيجاد الارتفاع المناسب لها مع العقود المستندة إليها بطريقة حسابية تختلف عن تلك التي اتبعت في جامع المتوكل لأن سقفه يستند على الأكتاف بدون عقود.
ولغرض تحليل الهدف من استخدام المعمار العربي للقياس (1/60م) عرضاً للكتف المستطيل هو الحصول على مربع طول ضلعه (1,60م) أساساً لاحتساب الارتفاع المناسب للأكتاف بعد رسمه على الورق أو الجلد وقبل تنفيذه البناء على
ص: 500
الأرض، وهو قياس لم يوضع اعتباطاً وإنما كان مدروساً وفق أسس هندسية لتثبيت ارتفاع الروافع مع الأقواس والسقوف معتمداً في ذلك على نسبة (1:3) وهي النسبة المطبقة نفسها في جامع سامراء على الرغم من الاختلاف في شكل الروافع.
ولأجل التحقق من صحة هذه العملية، فإن ما سنذكره من آراء تضعنا أمام احتمالات عدة منها:
1 - هو ان المهندس أو مقدم البنائين (1) نفذ مخططاً للكتف المستطيل، استخرج منه مربع طول ضلعه (1,60م) وقطره (226م) ، وعند تطبيق القانون (القطر × النسبة الثابتة) نحصل على : -
2,26م قطر المربع المستخرج من المستطيل × 22 / 7 النسبة الثابتة = 72 و 7/49 = 7/1م) وهو الارتفاع التقريبي للسقف والمثبت موقعياً.
ويمكننا إيجاد قطر المربع بموجب النظرية التي كشفت على لوح من تل حرمل، وهي نظرية سبقت النظرية التي تعزى إلى الرياضي إقليدس ومن ثم فيثاغورس بنحو (17) قرناً (القرن الثالث ق. م) ليمكننا إيجاد قطر المربع، مادام الضلعان القائمان معلومين لدينا، فالمقابل الجبري لهذا الحل الهندسي: -
مربع القطر = مجموع مربعي الضلعين القائمين (القطر 2) = (160م2) + (1/60م2) 512م2 = 2,56م2 + 2,56م2 اذا القطر = 2,26م وهو طول القطر نفسه على الأرض كما بينا ذلك سابقاً .
ويمكن القول إن مهندس العمائر حاول وضع مخطط تفصيلي لتثبيت الارتفاعات الجزئية التي يعتمد عليها البناء، ولغرض التأكد من صحة ذلك، ننفذ على الورق مخطط مستطيل الشكل يمثل الكتف بمقياس 1 / 50 وبالأبعاد المثبتة
ص: 501
3/60م× 1/600 م، وهو أنموذج للأكتاف التي نعدها أساساً لعملية احتساب هذه الارتفاعات (شكل 5).
أ - نرسم على الشكل المستطيل (شكل الكتف) نصف دائرة قطرها يساوي طول ضلع الكتف (3/60م ) ليمس محيطها الضلع الأعلى في نقطتين.
ب - نرسم عمودين من نقاط تماس محيط الدائرة على الضلع الأسفل من المستطيل للحصول على مربع طول ضلعه (1/60م) داخل محيط الدائرة، وعلى مستطيلين واقعين على جانبي المربع أبعاد كل منهما (1م× 1/60م) .
ج - ومن الممكن الإفادة من عرض أحد المستطيلين البالغ (1م) بعد إجراء عملية الضرب في نسبة الارتفاع (3) ليساوي (3م) ، والذي يمثل ارتفاع الكتف عن مستوى التبليط إلى بداية الإفريز المؤلف من ست سافات من الطابوق والذي يقوم مقام الوسائد، ويبلغ ارتفاع هذا الإفريز نصف متر، وهو يساوي طول أحد المستطيلين المرسومين(1).
د - اما ارتفاع قمة القوس عن الأرض فهو يتمثل باحتساب نصف قطر الدائرة المرسومة (1,70م) في حالة إضافة مجموع الارتفاعات الآتية :-
3 م (ارتفاع بدن الكتف) + نصف متر (ارتفاع الإفريز) + 1٫70م ارتفاع قمة القوس = 20, 5م ارتفاع قمة القوس عن الأرض، وهو الارتفاع المحدد موقعياً.
قد قمنا بفحص هذه الارتفاعات موقعياً، وهي مطابقة لكل ما استخرجنا من ارتفاعات مطلوبة ومن الاحتمالات المذكورة آنفاً التي أوردناها، مما يدل على أن المعمار في سامراء كان على دراية كاملة بعلوم الهندسة التطبيقية، وعلى اطلاع بعلوم
ص: 502
الهندسة والرياضيات، والتي تعد أساساً للدراسات الحديثة في استخدامات النسب الرياضية الثابية في العمارة الإسلامية العباسية، ومن الفكر الرياضي المعاصرة والتي تعتمد على الأسس المطبقة حالياً في معظم الأبنية العربية الإسلامية، وهي مقابلة تماماً للاحتمالات الآنفة الذكر (1).
وللتحقق من صحة النتائج التي توصلنا اليها، يستوجب الإشارة إلى ما ذكره المنقبان كل من بشير فرنسيس و محمود العينه جي من قياسات لأكتاف جامع أبي دلف في عام 1940م، وكما يأتي: -
1 - ترتفع الأكتاف (الدعائم كما تسمى خطأ) عن مستوى التبليط إلى الإفريز (3/03م) ، ويبرز في كل منها إفريز حتى انعطاف القوس بمقدار ست سافات من الآجر يبلغ ارتفاع 2/1م.
2 - يرتفع القوس من نقطة التجريد (التقوس) إلى الذروة (1,70م) ، وعلیه يكون ارتفاع ذروة القوس عن مستوى التبليط (5/23م52).
3 - وفي موضع آخر من نتائج التنقيب لاحظنا عند نقطة تعلو نحو (50سم) عن ذروة القوس في جهات متعددة من أروقة المصلى الباقية بهذا الارتفاع ثقوباً باستقامة واحدة تترواح ابعاد بعضها عن بعض ما بين (60 - 70سم) وقطر الثقوب بين (20 - 25 سم ) ... و ألظاهر ان السقف كان يرتفع عن مستوى التبليط نحو سبعة أمتار.
ص: 503
هذا ما استطعنا الوقوف عليه من حقائق موقعية وأدلة أثرية، تؤكد وجهة نظرنا من أن المعمار العربي اعتمد في البناء على تقاليد بنائية روعي فيها استخدام النسب الهندسية التي تتفق مع وظائف هندسة العناصر العمارية، وخضوعها للفكر الرياضي، وهي الأسباب التي أدت إلى ديمومة الفن المعماري العربي وبقائه متحدياً الزمن وعوامل الطبيعة.
ص: 504
الصورة
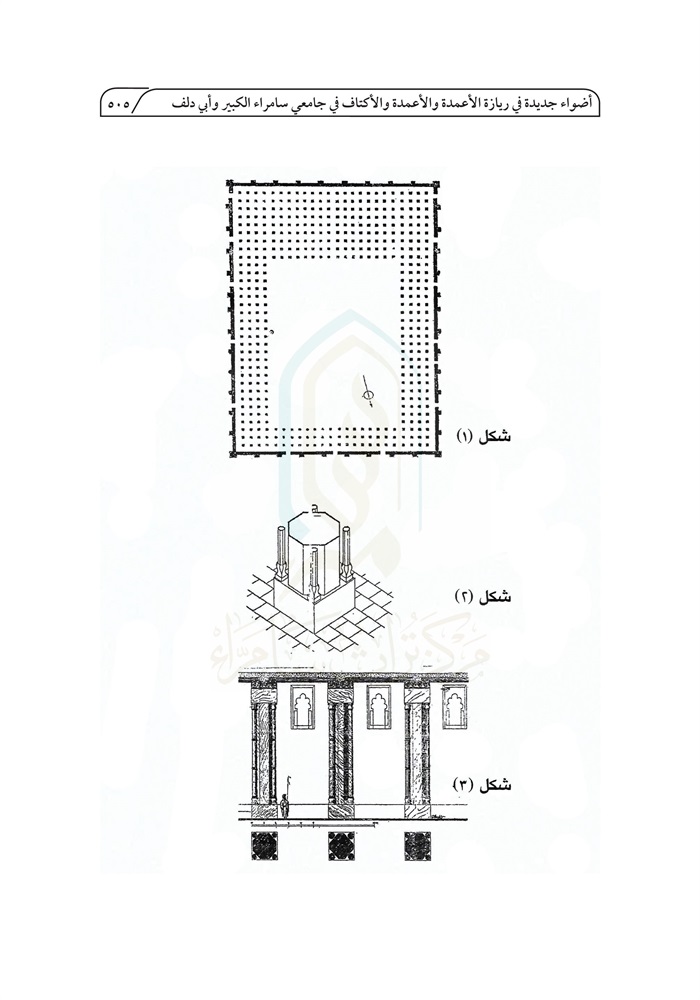
ص: 505
الصورة
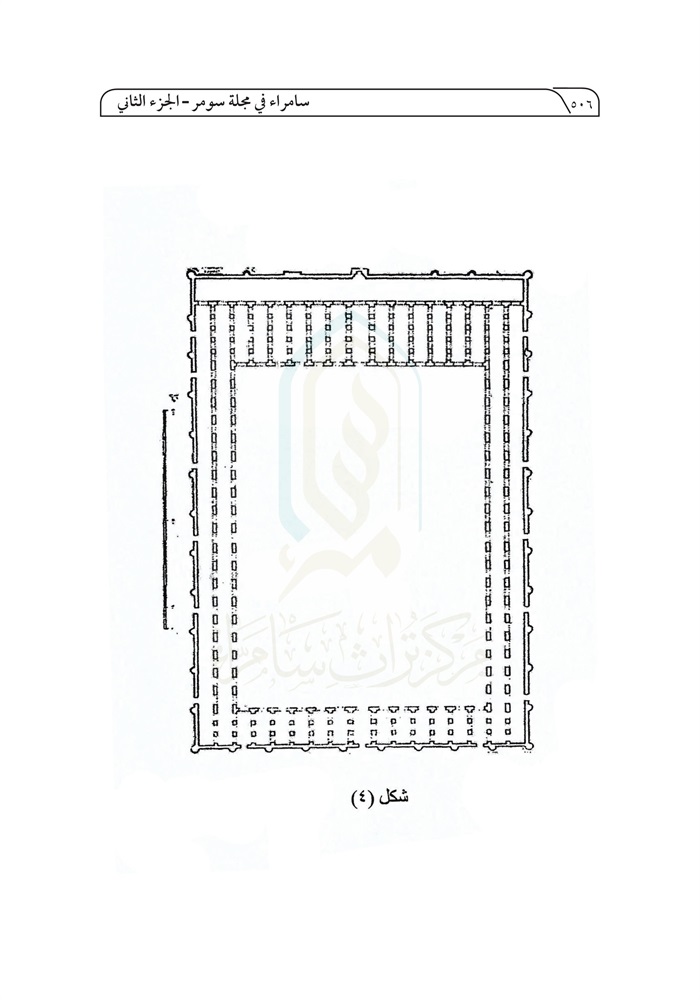
ص: 506
الصورة
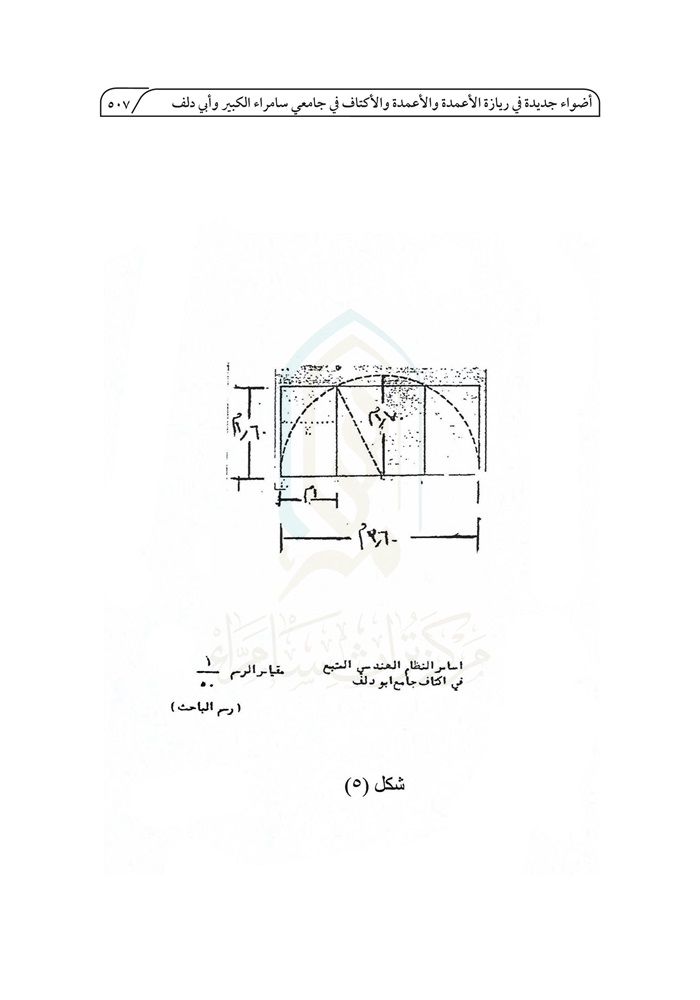
ص: 507
ص: 508
المجلد السابع والخمسون سنة 2012
د. إسماعيل محمود احمد
سامراء:
تقع مدينة سامراء على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وتبعد عن بغداد مسافة (130 كم) إلى الشمال، وقد بنيت على جزء من أطلال مدينة سامراء العباسية. تعد سامراء من المدن المهمة في التأريخ، كونها تشكل حلقة وتاريخاً واضحاً من سلسلة حلقات تأريخ العراق للفترات التي تقع قبل الإسلام وفي الفترات الإسلامية، لهذا اتجهت إليها أنظار الباحثين والمختصين للبحث والتنقيب وإبراز دورها الحضاري والإنساني في ذلك.
ويمكن للباحث في تأريخ سامراء أن يقسمه إلى حقبتين زمنيتين :
فالأولى : تمثل تأريخ سامراء القديم والذي يعود إلى عصور سحيقة في القدم، فقد عاشت على أرضها حضارة تسمى بحضارة تل الصوان، حيث عثر المنقبون في التل الواقع في جنوب سامراء، ما يدل على أن الحياة فيه استمرت لخمسة أدوار زمنية لكون التل مؤلف من خمسة طبقات سكنية، ومن تحليل المرافق البنائية والفخار والأواني والحزوز ،والنقوش، تبين أن تاريخه يعود إلى الألف السادس قبل الميلاد.
وأكد العالم الألماني هر ز فلد هذا التأريخ، عندما قام بالتنقيبات في منطقة (شبه الحاوي) الواقعة إلى الجنوب من قصر الخلافة على نهر دجلة، للأعوام (1912 / 1913) وعام (1931 / 1934م) انه عثر على آثار من الأواني والفخار
ص: 509
والخرز والأحجار ، تعود إلى فترة تل ،الصوان أي إلى نهاية العصور الحجرية القديمة وبداية العصور الحجرية الحديثة (1).
كما أمدت المدونات التأريخية بأسماء عديدة سميت بها مدينة سامراء، ففي المدونات الآشورية كانت تسمى (سامرتا)، إذ إن المدينة كانت تعد الحدود الجنوبية للدولة الآشورية، وفي العصر الروماني كانت تسمى (سيمارم)، وفي العصر الساساني أطلق عليها الساسانيون اسم (سومير)، نسبة إلى احد حصونهم العسكرية عند قتالهم للرومان وتراجعهم ومقتل جوليان عام 1363م . وأخذت مدينة سامراء بعد هذه الفترة تزدهر وتبرز أهميتها الزراعية، إذ إن أغلب مشاريع الإرواء عملت بعد هذا التأريخ للمدينة، ومن اهمها مشروع النهروان الذي يتألف بدوره من ثلاثة أنهار إروائية، وهي (خارطة رقم 1).
(1) نهر القائم: الذي يقع جنوب سامراء، وهو النهر الصيفي، ويأخذ مياهه من نهر دجلة عند رأس القائم.
(2) نهر الصنم: ويقع جنوب سامراء، وهو النهر الشتوي، ويأخذ مياهه من نهر دجلة.
(3) نهر القاطول الأعلى: ويقع في شمال سامراء، ويسير في شرقه نازلاً إلى الجنوب حتى مدينة الكوت، ويأخذ مياهه من نهر دجلة ايضا (2) .
وبالانتقال العصر الإسلامي، فإن بناء أية مدينة لابد أن يتوفر فيها عاملان حتی تأخذ صفة المدينة الإسلامية، وهذان العاملان هما: وجود السلطة السياسية والإدارية، والسلطة الدينية، أي وجود حاكم أو قاض في المدينة، ووجود المسجد الجامع.
ص: 510
والمدن في التأريخ تبنى لأسباب عديدة منها سياسية، أو عسكرية، أو تجارية، أو دينية، أو للراحة والاستجمام، ولكل مدينة مميزاتها التخطيطية والهندسية في البناء، ومدينة سامراء توفرت بها الكثير من مواصفات بناء المدن إن لم يكن جميعها، نظراً لإحاطتها بالمياه من جميع جهاتها وكثرة مشاريعها الإروائية، مما جعلها منطقة زراعية وسهولة وصول المراكب إليها بدجلة، ولهذا اتخذت عاصمة لبني العباس.
وقبل أن تبنى عاصمة للخليفة المعتصم كان الخليفة هارون الرشيد يأتي إلى سامراء متصيداً كلما ضجر من الحياة في بغداد، وقد أجرى عدة محاولات للسكن فيها، فقد حفر فيها النهر المعروف بأبي الجند، وبنى له قصراً عند فوهته، فذكر ياقوت الحموي عن القاطول نهراً كأنه مقطوع من دجلة وهو نهر کان في موضع سامراء قبل ان تعمر وكان الرشيد أول من حفر هذا النهر وبني على فوهته قصر أسماه أبا الجند لكثرة ما كان يسقي من الأرضين وجعله لأرزاق جنده) (1).
والمقصود هنا في رواية الحموي أن الرشيد أول من حفر هذا النهر أي أول أعاد من حفره لكثرة ما كان فيه من غرين وطمي نتيجة لما يحمله نهر دجلة من ترسبات في موسم الفيضان والمرور سنوات طويلة على بداية حفره وعدم استخدامه، مما أثرت فيه عوامل الطبيعة وطمرته.
وصحح ابن عبد الحق رواية ياقوت فقال: (إن القاطول نهر كان في موضع سامراء قبل أن تعمر حفره الرشيد) (2) .
وأيد المهندس أحمد سوسة رأي ابن عبد الحق ان النهر كان موجوداً قبل عهد
ص: 511
هارون الرشيد وان الرشيد أعاد فتحه (1)، وفي الكلام عن أنهار سامراء كتب سهراب عن نهر أبي الجند: (والثالث يقال له أبو الجند ، وهو الأسفل وهو أجلّها وأعمرها شاطئاً، يمر بين ضياع وقرى وتتفرع منه أنهار تسقي الضياع التي على شاطئ دجلة، ثم يمر في القاطول الكسروي فوق صلوى بأربعة فراسخ) (2).
وسبب حفر الرشيد لنهر أبي الجند، هو أن نهر القورج الواقع على مسافة (65 كم جنوب سامراء والذي كان يأخذ مياهه من دجلة، كان يهدد بغداد بالغرق أثناء فيضان نهر دجلة، مما دفع بالخليفة هارون الرشيد أن يسد فوهته ويحفر نهر أبي الجند تلافياً للغرق.
ويبدو من روايات التأريخ، أن الرشيد أراد بناء مدينة في سامراء، وليس قصراً الا أن ثورة أهل الشام حالت دون ذلك، وذكر كل من الطبري وابن الأثير عن رواية لمسرور الخادم، (ان مسرور الكبير قال: سألني المعتصم : اين كان الرشيد يتنزه اذا ضجر ببغداد ؟ قلت بالقاطول ، وكان قد بني هناك مدينة آثارها وسورها قائم، وكان قد خاف من الجند ما أخاف المعتصم، فلما وثب أهل الشام ،وعصوا، خرج إلى الرقة فأقام بها وبقيت مدينة القاطول لم تستتم) (3).
استلم الخليفة المعتصم بالله ابن هارون الرشيد الخلافة في بغداد سنة 218 ه_ / 838م ، وقام أولاً بإدارة شؤون الدولة من بيت للمأمون في بغداد، اتخذ مقرا له، وبعدها أقيم له دار بالجانب الشرقي من بغداد، سكنه للفترة 220/218 للهجرة، قبل انتقاله إلى سامراء (4).
ص: 512
وحين فكر الخليفة المعتصم باتخاذ سامراء عاصمة للدولة العربية الإسلامية، لم يكن اختياره للموضع كيفما شاء، وإنما جرت محاولات عديدة قبل أن يستقر رأيه على موقع سامراء.
فخرج في نهاية عام 220 للهجرة، باحثاً عن موضع لبناء مدينة تكون عاصمة له بدلاً من بغداد، نتيجة أسباب عديدة دعته للخروج من بغداد وتركها، فيروي اليعقوبي رواية بحث المعتصم عن مكان لعاصمته الجديدة (فثّقل ذلك على المعتصم وعزم على الخروج من بغداد فخرج إلى الشماسية، وهو الموضع الذي كان المأمون يخرج إليه فيقيم به الأيام والشهور، فعزم أن يبني في الشماسية خارج بغداد مدينة فضاقت عليه أرض ذلك الموضع وكره أيضاً قربها من بغداد، فمضى إلى البردان بمشورة الفضل بن مروان وهو يومئذ وزير، وذلك في سنة احدى وعشرين ومائتين، وأقام بالبردان أياماً وأحضر المهندسين ثم لم يرض الموضع ، فصار إلى موضع يقال له باحمشا في الجانب الشرقي من دجلة، فقدر هناك مدينة على دجلة وطلب موضعاً يحفر فيه نهراً ، فلم يجد منفذاً إلى القرية المعروفة بالمطيرة، فقام بها مدة ثم مد إلى القاطول فقال هذا أصلح المواضع، فصير النهر المعروف بالقاطول وسط المدينة ويكون البناء على دجلة وعلى القاطول) (1). وجاء في فتوح البلدان للبلاذري أثناء حديثه عن سفر المعتصم إلى القاطول (فنزل قصر الرشيد كان قد ابتناه حين حفر قاطوله) (2).
باشر المعتصم البناء بالقاطول ووزع الأراضي على القادة وأفراد الجيش الموظفين والناس، وعين مكان الأسواق وابتدأ البناء وارتفع إلى ارتفاع معين.
غير إن الحموي نفى أن يكون المعتصم قد بنى مدينة في القاطول، وإنما بنى
ص: 513
قصراً، ووهب القصر فيما بعد لقائده اشناس(1).
ويضيف المسعودي، ان منطقة القاطول التي على دجلة كانت قرية يسكنها قوم من الجرامقة، وناس من النبيط (2).
وقد قال بعض العيارين للمعتصم حين انتقل من بغداد إلى القاطول:
أيا سكن القاطول بين الجرامقة تركت ببغداد الكباش البطارقة (3).
غير ان موضع القاطول لم يعجب الخليفة المعتصم، حيث أصابته بردة عظيمة، إضافة إلى شدة أرض القاطول ، فينقل المؤرخون (أن أرض القاطول غير طائلة، وانما هي حصى وأفهار، والبناء بها صعب وليس لأرضها سعة) (4)، فانتقل بعدها إلى سامراء.
بناء سامراء: قدم لنا اليعقوبي رواية عن اختيار المعتصم موضع سامراء عاصمة له : (ركب متصيّداً فمر في مسيره حتى صار إلى موضع سر من رأی صحراء من أرض الطيرهان لا عمارة بها ولا أنيس فيها الا دير للنصارى، فوقف بالدير وكلّم من فيه من الرهبان وقال: ما اسم هذا الموضع ؟ فقال له بعض الرهبان نجد في كتبنا المتقدمة أن هذا الموضع يسمى سر من رأى وانه كان مدينة سام بن نوح، وانه سيعمر بعد الدهور على يد ملك جليل مظفر منصور، له أصحاب وجوههم وجوه طير الفلاة، ينزلها وينزلها ولده، فقال: انا والله أبنيها وينزلها ولدي) (5).
لم تكن سامراء كما ورد في رواية اليعقوبي بانه لا عمارة بها ولا أنيس عندما
ص: 514
قدم إليها المعتصم ، بل كانت مسكونة من قبل الجرامقة والنبيط ، وكانت فيها قرى وضياع عامرة تقع على مجاري الأنهار ، وكما أشارت رواية تاريخية أخرى إلى وجود العديد من الأديرة غير الدير الذي اشتراه المعتصم فكان فيها (دير السوسي)، يقع على دجلة بقادسية سامراء، وبينه وبين سامراء أربعة فراسخ، وكان محاطا بالبساتين والكروم والمتنزهات فكان الناس يقصدون هذا الدير ويشربون في بساتينه، والدير الآخر (دير مرمار) ويقع جنوب سامراء، كان عامرا وحوله كروم وشجر ، وهو من مواضع النزهة.
وفي قرية المطيرة في الجنوب كان هناك ديران احدهما يسمى (دير ماسرجيس)، والاخر (دير عبدون) وهو نصراني أسلم أخوه صاعد بن مخلد، واستوزره الموفق، فهذه الاديرة لابد وان يكون هناك أناس كثيرون يتعبدون بها، غير ان ما جاء في رواية اليعقوبي، هو ان المنطقة التي نزل عندها المعتصم لم يكن فيها سوى هذا الدير(1).
وأمر المعتصم كل من محمد بن الملك الزيات، وابن أبي داوود، وعمر بن فرج، واحمد بن خالد المعروف بأبي الوزير، واشتروا الدير من أصحابه ودفعوا لهم أربعة آلاف دينار.
وللمعتصم أسبابه التي دفعته لبناء عاصمة جديدة، هي رغبته في بناء مدينة تخلد ذكراه، إضافة إلى سوء معاملة الجند الترك لأهل بغداد الذين اعتمد عليهم المعتصم في جيشه.
والعامل الآخر، هو الري والمياه، وقد اشار عليه الخبراء الذين كانوا برفقته من ان دجلة تكون حدودها الغربية، والقاطول من شمالها وشرقها، والقاطول الأسفل من جنوبها، وهذه المياه توفر للمدينة الحماية الكافية من الاعداء وتؤمن للعاصمة المياه الكافية.
ص: 515
التخطيط الجغرافي لبناء سامراء في عهد المعتصم:
استقر رأي المعتصم على بناء سامراء فأحضر المهندسين والبنائين والحرفيين والفعلة والصناع من جميع أرجاء الدولة العربية الإسلامية، وقسم المدينة إلى احياء وقطائع ومساجد وشوارع وساحات ومتنزهات وأسواق، كل حسب عمله وحرفته وصناعته وهذا يدل على براعة الخليفة في هندسة المدينة وتخطيطها، كما فعل أبو جعفر المنصور في تخطيط بغداد، وامتد طول البناء عشرة كيلو مترات إلى الشمال عند حدود شناس وعشرة كيلو مترات إلى الجنوب من نهر القاطول الأسفل، وفتحت الشوارع الرئيسة والفرعية وامتد البناء على جانبيها، (خارطة رقم 2).
وقد أقطع المعتصم قائده شناس قطيعة في آخر أبنية سامراء من الشمال في
الموضع المعروف بكرخ سامراء، وأسكن معه عدداً من القادة والرجال، ولا تزال أسوار هذه القطيعة قائمة إلى الوقت الحاضر ، وبداخلها بقايا أبنية القصور والمنازل (1)، وبجانبه يشاهد الآن سور ضخم يقع إلى الجهة الشمالية الغربية من سور شناس، ويضم عدداً من الأبنية، يسمى سور الشيخ ولي، ويعتقد المهندس أحمد سوسة ان الأبنية التي بداخل السور ربما تكون قد خصصت لنساء القادة والعسكريين، وأقطع قوم آخرين مكاناً فوق كرخ سامراء، وسماه الدور، وكان يعرف (بدور العرباني) أو دور عربايا لتميزه عن مكان آخر يسمى الدور يقع جنوب تكريت التي فيها قبر الامام محمد الدوري، وأطلق عليه الدور الأعلى.
وكان في الدور العرباني قبل أن تبنى وتسكن في وقت المعتصم دير يسمى (دير الطواويس)، وانه كان في سابق الزمان منظره لذي القرنين، ويقال لبعض الأكاسرة، فاتخذه النصارى ديراً في أيام الفرس يتعبدون فيه، أما في جنوب سامراء فأقطع المعتصم قائده الأفشين الاسروشني في آخر بناء سامراء في
ص: 516
الموضع المسمى ( المطيرة)، وضم إليه أصحابه الأسروشنية وغيرهم، وأمرهم ببناء دورهم حول دار الأفشين وبناء سويقة فيها حوانيت للتجار ومساجد وحمامات، وكانت المطيرة تبعد عن سامراء مسافة فرسخين، الا انه حالياً لا يمكن تحديد قرية المطيرة ودار الأفشين لكثرة الخرائب الأثرية (1)، والمطيرة قرية بناها مطير بن فزارة الشيباني فنسبت اليه وجاء في كتاب آثار البلاد وأخبار العباد (المطيرة من قرى سامراء أشبه أرض الله بالجنان من لطافة الهواء وعذوبة الماء وطيب التراب وكثرة الرياحين، وهي من متنزهات بغداد يأتيها أهل الخلاعة ) (2) ، وفي المطيرة دير عبدون النصراني الذي قال فيه الشاعر ابن المعتز :
سقى المطيرة ذات الظل والشجر *** ودير عبدون هطال من المطر
ونزل المعتصم بدار العامة أو الجوسق الخاقاني الذي يتوسط مدينة سامراء، وفتحت الشوارع ووزعت القطائع والحارات، فتم فتح خمسة شوارع رئيسة في عهد المعتصم، تقاطعها الشوارع الفرعية وتتصل بعضها ببعض، فتحت بالشكل التالي:
(1) شارع الخليج : كان يسير بمحاذاة نهر دجلة، حيث السفن والمراكب التي ترد من بغداد وواسط وكسكر والبصرة، والأبلة والأهواز، ومن الموصل وديار ربيعة، وتقع على هذا الشارع قطائع المقاربة ورجالهم .
(2) شارع السريجة أو (الشارع الأعظم): ويعد الشارع الرئيس في المدينة، وبلغ طوله في عهد المعتصم تسعة عشر كيلومترا من دور العرباني وسور شناس شمالاً، إلى المطيرة جنوباً، وعلى هذا الشارع بنيت الدور والقصور والمساجد والأسواق والدواوين، فكانت تقع عليه قطيعة إسحاق بن إبراهيم، وقطيعة إسحاق بن يحيى بن معاذ، وقطائع قادة خراسان، منها قطيعة هاشم بن
ص: 517
يانجور وعجيف بن عنبسة والحسن بن علي المأموني وهارون بن نعيم وقطيعة و حزام بن غالب، وفي ظهر قطيعة ابن غالب بنيت اصطبلات من قبل الخليفة وعامة الناس لكون المسؤول عنها حزام بن غالب، كما كان عليه موضع الرطابين وسوق الرقيق، حيث الغرف والحجر والحوانيت للرقيق، ثم كان عليه ديوان الخراج ومجلس الشرطة والجيش ومنازل الناس والأسواق والبياعات والصناعات يمنه ويسرة على هذا الشارع ثم السوق العظمى الرئيس وجامع سامراء الكبير الذي بناه المعتصم والذي بقيت الصلاة فيه إلى عهد المتوكل، حيث ضاق على الناس فهدمه أو تركه وبنى جامع الملوية الحالي بدلاً عنه.
وكانت على هذا الشارع دار العامة وقطيعة مبارك المغربي وسويقته، وقطيعة جعفر الخياط، والوزير والعباس بن علي بن المهدي، وعبد الوهاب بن علي بن المهدي، وتمتد هذه الوقائع إلى دار الواثق قرب دار العامة وقطيعة مسرور الخادم و قرقاس الخادم وثابت الخادم وسائر الخدم الكبار ، كما كان عليه خزائن العامة والخاصة (1).
(3) شارع أبي أحمد : كان يسير هذا الشارع بموازاة الشارع الأعظم من الشمال إلى الجنوب، تتوزع على جوانبه قطائع الناس ودورهم فتقع عليه قطائع قادة العرب وخراسان وأهل قم وأصبهان وقزوين وأذربيجان، ودار بخشوع المتطبب على الجهة الشرقية من بداية هذا الشارع ، وهو من أسرة سريانية كانت حلقة الوصول لنقل العلوم بين الحضارة العربية واليونانية، وقطيعة عمر والكتاب واحمد بن الرشيد، التي تقع في وسط الشارع، وفي نهاية الشارع من الجنوب هناك قطائع ابن أبي داوود، والفضل بن مروان ومحمد بن عبد الملك الزيات، وعند التقاء هذا الشارع بالشارع الأعظم هناك قطيعة بغا الصغير وبغا الكبير وسيما الدمشقي وبرغامش ووصيف، وقطيعة ايتاخ حتى يتصل بقصور
ص: 518
الخلافة (1).
(4) شارع الحير الأول: يقع إلى الشرق من شارع أبي أحمد، وموازياً له، ويمتد من وادي إبراهيم بن رياح في الشمال، وحتى وادي إسحاق بن إبراهيم في الجنوب، وتقع عليه قطائع الجند الشاكرية وأخلاط الناس (2).
(5) شارع برغامش التركي: يقع في آخر شوارع مدينة المعتصم من جهة الشرق، بموازاة شارع الحير الأول وامتداده كان من وادي إبراهيم بن رياح في الشمال وحتى قرية المطيرة وقطيعة الأفشين في الجنوب، وكانت تقع عليه قطائع الأتراك والفراعنة والخزر (3).
الوديان:
اخترق مدينة سامراء وشوارعها واديان طبيعيان، الأول: يقع في شمال المدينة، ويسمى وادي إبراهيم بن رياح يقع قرب سور شناس، وسمي بهذا الاسم لان قطيعة إبراهيم كانت تقع عند رأسه والمستغل حاليا لجريان الماء فيه إلى نهر الرصاصي. والثاني يقع في الجنوب، والمسمى وادي إسحاق بن إبراهيم، ويسمى عند الناس بوادي الموح، وكان هذان الواديان يقعان في العصر العباسي وسط المنطقة المتوجة للمدينة، ويأخذان مياه الأمطار أو المياه الزائدة ويرجعانها إلى نهر دجلة.
هذا بخصوص عمارة الجانب الشرقي للمدينة التي قام بها الخليفة المعتصم، أما المشاريع والأبنية في الجانب الغربي لنهر دجلة، فمن أهمها إحياء نهر الإسحاقي.
ونهر الإسحاقي يرجع إلى عصور سحيقة، وإنه نهر جسيم فيما مضى من
ص: 519
الزمان، كان يأخذ مياهه من الضفة الغربية لنهر دجلة من نقطة تقع إلى الجنوب من تكريت عند منقطة العوجة حالياً، ويسير متعرجاً في الأراضي التي تقع شمال غرب سامراء، ثم ينعطف عند منطقة قصر العاشق ويحيط بالقصر من جهتيه الشمالية والشرقية ، ثم يأخذ مساره باتجاه الجنوب حتى اذا ما وصل إلى محطة قطار سامراء (القلعة) انشطر إلى قسمين يسير القسم الأيمن باتجاه الجنوب الغربي ليسقي أراضي الجزيرة لمناطق سامراء والفرحاتية وبلد والدجيل، حتى يصل إلى عقرقوف، أما القسم الأيسر فيسير باتجاه الجنوب الشرقي قليلاً ليسقي أراضي جنوب سامراء، حتى ناحية الإسحاقي والى الكاظمية.
ولمرور فترة طويلة على حفر النهر، فقد اندثر بسبب ترسبات الغرين وخرب مجراه وتهدمت جوانبه، فلم يعد صالحاً لجريان الماء فيه، فقرر المعتصم إعادة حفره لكون الجانب الشرقي من سامراء ازدحم بالسكان ولم تكن هناك اراض كافية لزراعتها والتنزه فيها، فأراد أن يكون الجانب الغربي هو متنفس المدينة ومكان نزهتها، فقام الخليفة بحفر الجزء العلوي منه، والذي يبدأ من جنوب تكريت حتى منطقة الاصطبلات في جنوب سامراء، أما الفرع الذي يصل إلى عقرقوف فقد ترك بدون إصطلاح، وقد شيد المعتصم على الإسحاقي بعض الأبنية، منها ، قصره المعروف بالحويصلات (قصر الجص) لبنائه بمادة الجص والحصى الكبيرة، وقبة الصليبية، ومعسكر الاصطبلات، وأخيراً أنشا الخليفة المعتمد عليه قصر العاشق، إضافة إلى العديد من القرى والضياع، فكان نهر الإسحاقي محور العمران في الجانب الغربي للمدينة.
واتصل هذا الجانب بالجانب الشرقي من سامراء، اي مركز المدينة، بواسطة جسر يقوم على أكتاف وعقود بنيت بالحجارة والنورة، يفصل المنطقة بين قصري الجوسق الخاقاني وقصر العاشق، وقد غمر بمياه نهر دجلة، وفيما بعد خرب.
ص: 520
وامتدت المزارع على جانبي نهر الإسحاقي، فحمل إلى الأراضي المزروعة النخيل من بغداد والبصرة ومن سائر سواد العراق، وحملت الأشجار من الجزيرة والشام والري والجبل وخراسان، فزكت الثمار وحسنت الفواكه وطابت الرياحين، لكون الأرض نشطة التربة ولم تزرع لألاف السنين وقد سكن الناس القرى والضياع، وبلغ عددها اثني عشر قرية خمس منها في الشمال وسبع في الجنوب، وكانت عامرة باهلها وزروعها، وبلغ خراج الزرع اربعمائة الاف دينار في السنة (1).
وهذا ما حدا بالقزويني بان يصف سامراء بانها (أعظم بلاد الله بناء وأهلاً وانها لم يكن في الأرض أحسن ولا أجمل ولا أوسع ملكا منها ) (2).
تخطيط سامراء على عهد المتوكل:
استلم الخليفة المتوكل على الله زمام الخلافة في سامراء سنة 846/232م، ودام حكمه خمسة عشر عاما، حتى عام 247 861م، وامتاز عصره بالعمران، ويعد من أحسن الخلفاء الذين عمروا وشيدوا في سامراء.
سكن أول عهده بالجوسق الخاقاني، أي دار العامة، وقام ببناء العديد من القصور وأدخل التوسعات والإضافات إلى مدينة المعتصم، الا انه شعر ان هذه الأعمال لا تلبي رغباته فقرر بناء مدينة تخلد ذكراه وتشبع رغباته العمرانية، ويتخذها مقراً لعاصمته، وهذا ما حققه عند بناء عاصمته الجديدة المتوكلية، الواقعة إلى الشمال من سامراء، فأمر مهندسيه بتخطيط المدينة ووضع تصاميمها الهندسية بقصورها ومساجدها وشوارعها وساحاتها وأنهارها ومتنزهاتها.
واراد ان يطلع على تخطيط المدينة ويعطي رأيه بتصميمها قبل المباشرة بالعمل، لان الخلفاء كانوا يتدخلون بإعطاء ملاحظاتهم بشكل مباشر عند تنفيذ أية مدينة أو مشروع.
ص: 521
لم يكن تخطيط المدن من الأمور المرتجلة، لان تنفيذ أي مشروع كانت تعد له الخرائط والرسومات والكتابات والزخارف وحسابات الكلفة والنفقات الواجب صرفها، ويبدأ المهندسون بوضع العلامات على الأرض وتخطط بالرماد والكلس قبل المباشرة بالعمل ومعاينتها من قبل الخليفة والمهندسين لتلافي الاخطاء التي تقع بالبناء.
فالخليفة عمر بن الخطاب (رض) كان يعطي تعليماته لقادته عند بناء المدن، فقد القائد عتبة بن غزوان عند تأسيسه مدينة البصرة (عام - 14 هجرية)، أن تكون على مقربة من الماء والمرعى وعلى طرف الصحراء، ففي رسالته للقائد عتبة (ارتد لهم منزلا قريبا من الماء والمحتطب) (1)، ووجه القائد سعد بن أبي وقاص بعدم سكنى المدائن ، حيث لاحظ تغير ألوان وسحن المسلمين الوافدين إلى المدينة من المدائن فاستفسر من القائد سعد عن ذلك فأجابه (ان العرب خددهم وكفى ألوانهم خمومة المدائن ودجلة) (2)، وأمر بعدم سكنى المدائن وبناء الكوفة عام (17 للهجرة) لأنها أرض كانت تنبت فيها الاقحوان والشقائق والرياحين والخزامى.
وعندما استأذنه القائد عمر ابن لعاص بسكن الاسكندرية قال له الخليفة عمر : (إني لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلاً يحول الماء بيني وبينهم في شتاء وصيف، فلا تجعلوا بيني وبينكم ماء متى أردت أركب اليكم راحلتي حتى أقدم اليكم قدمت) (3).
وقد أمر بتقسيم المدن على أساس قبلي، وأن تكون بيوت أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله في البصرة والكوفة قريبة من المسجد (4).
ص: 522
وفي العصر الأموي عمل نموذج مجسم لقبة الصخرة التي بناها الخليفة عبد الملك بن مروان عام (72 هجرية) فأعجب بها وأمر ببنائها (1).
وأبو جعفر المنصور رسمت له بغداد بالرماد، ووضع عليها حبل قطن وأشعلت ليلاً ليرى تخطيطها قبل المباشرة بالعمل عام (145 للهجرة ) (2).
وهكذا كان حال الخلفاء والقادة عند بناء مدنهم، فالمتوكل عندما باشر بالبناء انتقل إلى قرية المحمدية التي تقع إلى الشمال من قطيعة شناس، وبالقرب من قرية المأجورة للأشراف على أعمال البناء بنفسه.
اختلفت آراء المؤرخين في قرية المحمدية، فذكر البعض انها تعرف بالإيتاخية نسبة إلى إيتاخ ،التركي، فسماها المتوكل المحمدية باسم ابنه محمد المنتصر غير ان ابن سرابيون ذكر أن الإيتاخية ليست المحمدية، فالإيتاخية في الشمال والمحمدية في الجنوب منها، وتقعان على نهر القاطول وكان عند قرية الإيتاخية جسر من الحجارة، وعند قرية المحمدية جسر من الزوارق (3).
وابتدأ البناء فبنيت القصور للخليفة وقادته وبنيت الدور للناس، والجوامع في العاصمة الجديدة، يقول ياقوت الحموي: (لم يبن أحد من الخلفاء بسر من رأى من الأبنية الجليلة مثل ما بناه المتوكل) ، وان مجموع ما أنفق من الأموال بلغ (294 مليون درهم) (4) .
وامتدت الشوارع الرئيسة من سامراء إلى المتوكلية واتصلت بها الشوارع الفرعية، الا انها كانت منتظمة ومستقيمة بين كل حارة واخرى ويمكن للمشاهد أن يرى آثارها وتقسيماتها إلى اليوم وتركت فراغات كبيرة بين قطائع
ص: 523
الناس ودورهم التي كانت تزرع بالنخيل والأشجار، وتسقى من نهر القاطول ولتوسع مدينة سامراء والمتوكلية وامتداداها فقد قام الخليفة المتوكل بفتح شارعين آخرين (خارطة رقم 3) وهما :
(1) شارع الأسكر (العسكر) ويقع خلف شارع برغامش التركي من جهة الشرق، وسمي شارع صالح العباسي، لكون دار صالح العباسي تقع فيه على رأس الوادي الشمالي، وفيه من قطائع الأتراك والفراغنة.
(2) شارع الحير الجديد : يقع إلى الشرق من شارع الاسكر وبموازاة نهر ،القاطول يسكنه اخلاط من الناس من فراغنة واسروشنية واشتاخنجية، ومن سائر کور خراسان.
وبذلك أصبح مجموع شوارع سامراء والمتوكلية سبعة شوارع، تخترقها من الشمال إلى الجنوب، وتتصل مع بعضها البعض، ومع نهر دجلة من الغرب ونهر القاطول من الشرق، الا أن أهمها وأوسعها الشارع الأعظم الذي بلغ عرضه (100 ذراع) (1) .
وأراد المتوكل عزل قصوره ومقر الحكومة والدواوين عن عامة الناس، فبنى سوراً كبيراً في نهاية العمران، من الشمال يصل بين دجلة ونهر القاطول، وفتحت فيه ثلاثة مداخل كبيرة عند الشارع الأعظم، يستطيع الفارس اجتيازها برمحه(2)، ومن أعظم القصور التي بناها المتوكل لنفسه هو قصر الجعفري، الواقع في أقصى شمال المتوكلية عند تقاطع نهر دجلة بنهر القاطول ، وقد أنفق عليه مبالغ كبيرة، بلغت ألفي ألف دينار، وكان مصدر إلهام للشعراء والكتاب، بناه سنة (245 للهجرة) وانتقل إليه عام (246 للهجرة)، وسكنه لتسعة أشهر وثلاثة ايام،
ص: 524
فقتل ودفن فيه (1).
وتذكر المصادر التاريخية ان المتوكل بني العديد من القصور، الا انه لم يتمكن المنقبون والباحثون من التعرف عليها، فمنها الجعفري المحدث، وقصر بستان الإيتاخية واللؤلؤة والبديع والبرج والبهو والسندان والصبيح والعروس والمختار والغريب(2). وبعد أن أكمل المتوكل بناء مدينته قال: (الان علمت اني ملك إذ بنيت لنفسي مدينة أسكنها).
ولمدينة سامراء منزلة عظيمة في التأريخ الإسلامي، ففيها ضريحا الأمامين علي الهادي وولده الحسن العسكري علیهماالسّلام، والإمام علي الهادي عاش في سامراء على عهد المعتصم، ولما توفي عام (254 للهجرة) دفن في داره، وفي عام (260 للهجرة) توفي ولده الحسن العسكري، ودفن إلى جواره في المنطقة المعروفة بالعسكر (3)، وقد أقيمت عليها قبة كبيرة تعد من أجمل القباب وأوسعها للأضرحة العراقية عام (1200 للهجرة) وطلي بالذهب والى جانبها قبة جميلة أيضاً غطي سطحها القاشاني المزخرف بالزخارف النباتية فوق غيبة المهدي، يحيط بهما صحن واسع سوّر بسور عال تعلوه شرفات أثرية (4)، وأحيطت سامراء الحالية بسور ضخم عام (1834م) بلغ قطره (680 مترا) وقد تهدم أغلبه الا الشيء القليل (5) .
ص: 525
حکمت سامراء من قبل ثمانية خلفاء:
(1) المعتصم 218 / 227 للهجرة / 838 / 842م
(2) الواثق 227 / 232 للهجرة / 842 / 847 م
(3) المتوكل 232 / 247 للهجرة / 847 / 861م
(4) المنتصر 247 / 248 للهجرة / 862/861م
(5) المستعين 248 / 251 للهجرة / 862 / 866م
(6) المعتز 251 / 255 للهجرة / 866 / 869م
(7) المهتدي 255 / 256 للهجرة / 869 / 870م
(8) المعتمد 256 / 279 للهجرة / 87 / 892م
واندرست سامراء وتلاشت معالمها، ولم تدم لها الحياة كعاصمة للخلافة الإسلامية سوى (58 سنة) بعد أن هجرها الخليفة المعتمد هجرها الخليفة المعتمد وارجع العاصمة إلى بغداد.
ان مدينتي سامراء والمتوكلية بلغتا من السعة والعظمة ما لم تبلغه مدينة في تلك الفترة، فامتدت مسافة تزيد على أربعين كيلومترا من الشمال إلى الجنوب، وبمعدل من ثلاثة إلى خمسة كيلومترات من الشرق إلى الغرب، فشكلت مساحة حوالي ( 160 كم مربع) ، ولو أضفنا إليها مساحة حير الوحوش والاصطبلات وساحات سباق الخيل والمزارع والبساتين، والتي على جانبي دجلة لأصبحت مساحتها تزيد على (300 كم مربع)، ولهذا عدها الآثاريون والمختصون من أكبر مدن العالم الإسلامي آنذاك (1).
وانها تضاهي أكبر المدن في العالم الحديث، يقول المهندس الدكتور محمد صالح مكية عن تخطيط المدينة وخصوصا المتوكلية هي اشبه بمربعات الشطرنج، والفضاءات الموجودة بين الاحياء السكنية وتنظيم الشوارع بفضاءاتها واستقاماتها
ص: 526
وتقاطعاتها وتعامداتها، وخصوصا الشارع الأعظم (يتشابه مع التطور الحديث لكثير من المدن العالمية اليوم، كمدينة نيويورك وغيرها من المدن التي تجمع بين الاحياء المختلفة، وتضمن ملتقى الشوارع العمودية م الأراضي إلى قطع هندسية منتظمة، فمدينة نيويورك اتجهت إلى الصيغة الشطرنجية، وللشوارع أرقام ، وهكذا يتضح الشبه في طابع الاختطاط بين مدينة المتوكلية ونيويورك، لا سيما اذا قايسنا البارك الأعظم) لمدينة نيويورك (بالقصر الأعظم)، وهو قصر الخليفة) (1).
وقد تخلفت من سامراء العديد من الآثار والقصور شاخصة إلى اليوم، وهي تحكي قصة مدينة عجيبة دام عمرها نصف قرن، وهي تعد اليوم من أهم العواصم الإسلامية، الا أنها أغنت الدارسين والباحثين بمعلومات كبيرة عن تخطيط المدن الإسلامية، وعن العمارة وطرازها والفنون الخزفية والزخرفية وصناعتها، لكون جميع العواصم الإسلامية التي سبقتها كالبصرة والكوفة وواسط والفسطاط والقيروان وبغداد المدورة ، قد اندثرت معالمها نتيجة الزحف السكاني عليها، ولهذا اعتمدتها منظمة اليونسكو مدينة مهمة وضمتها ضمن ممتلكاتها الثقافية، لا أريد التحدث عن الآثار المتخلفة من عاصمة بني العباس بالشرح والتفصيل لأن موضوع البحث سيطول كثيرا، وانما أردت ذكرها بشيء يسير وتعيين مواقعها حتى تكتمل الخارطة الجغرافية للمدينة، لكونها المصادر المرئية والملموسة، إضافة إلى ما ورد في روايات المؤرخين وهي:
(1) جامع الملوية : بنى الخليفة المعتصم الجامع الكبير عام (221) لهجرة / 836م) عند إنشاء سامراء على طرف الحير، واستمرت الصلاة فيه إلى عهد المتوكل، وعندما ضاق بالمصلين تركه المتوكل وبنى الجامع الحالي، جامع الملوية،
ص: 527
ولم يبنه في المكان نفسه الذي بنى به المعتصم الجامع الأول فكما جاء في رواية اليعقوبي ان المتوكل (بنى مسجدا جامعا فأعظم النفقة عليه وأمر برفع منارته لتعلو أصوات المؤذنين فيها وحتى ينظر إليها من فراسخ، فجمع الناس فيه وتركوا المسجد الأول) (1)، بدأ المتوكل بإنشائه عام (234 للهجرة / 849م) وفرغ من بنائه عام (237 للهجرة / 852م) ، ويعد الجامع من أكبر الجوامع في العالم الإسلامي، ولم يبق منه سوى أسواره الخارجية والمئذنة المبنية بالطابوق والجص (صورة رقم 1).
(2) جامع أبي دلف: يقع في المتوكلية بناه الخليفة المتوكل ويشبه في تخطيطه ومئذنته جامع الملوية، ويقع على بعد حوالي (20 كم) من سامراء في نهاية الشارع الأعظم، ولا يعرف بالتحديد تأريخ بناء هذا الجامع، الا انه بنى في عهد المتوكل، وكما ورد في رواية البلاذري، ان المتوكل أحدث المتوكلية ( وجعلها فيما بين الكرخ المعروف بفيروز وبين القاطول المعروف بکسری فدخلت الدور والقرية المعروفة بالماحوزة فيها وبنى بها مسجداً جامعا) (2)، والمتبقي من الجامع الآن مئذنته وبعض جدرانه الداخلية وبعض الأكتاف والعقود، أما الأسوار الخارجية فقد تهدم الكثير منها .
(3) قصر الخلافة أو دار العامة: يقع على الشارع الأعظم على حافة نهر دجلة الشرقية، بني على عهد الخليفة المعتصم ، كان يجلس فيه الخليفة يومين في الاسبوع للنظر في مظالم الناس واحتياجاتهم، بلغت ابعاد القصر (700 متر) من الشمال إلى الجنوب وهي الواجهة المطلة على نهر دجلة، أما من الشرق إلى الغرب فبلغ طوله (800 مترا)، وان بناية الدار أنشئت مكان الدير الذي اشتراه المعتصم، وكان به بيت المال، وقد نقب فيه العالم الفرنسي فيوله والعالم الالماني ،هرزفلد، ورسما
ص: 528
خريطة لمشتملات القصر ، ولم يبق منه في الوقت الحاضر سوى مدخله المؤلف من ثلاثة أواوين تطل على نهر دجلة(1)، (خارطة رقم 4 مع صورة رقم 2) .
(4) القصر الهاروني: بناه الخليفة هارون الواثق على نهر دجلة إلى الغرب من قصر الخلافة في المنطقة المعروفة بالكوير وأثره على جميع قصور المعتصم، وكان الجسر الذي يربط الجانبين الشرقي والغربي من سامراء يمر من أمامه (2).
(5) قصر الحويصلات يقع قصر الحويصلات على بعد حوالي (17 كم) : شمال سامراء في الجانب الغربي من نهر دجلة وعلى الجانب الأيسر من نهر الإسحاقي، بناه الخليفة المعتصم بالحصى الكبيرة والجص، واتخذه للنزهة والاستجمام (3) ، (خارطة رقم 5) .
(6) قصر المنقور / بلكوارا: يقع جنوب مدينة سامراء وعلى بعد (6كم) منها، قرب قرية المطيرة، بناه الخليفة المتوكل، ووهبه لابنه المعتز، وقد نقب العالم الالماني هر زفلد فيه وكشف عن تفاصيل القصر المعمارية(4)، (خارطة رقم 6 ) .
(7) قصر العاشق : يقع شمال سامراء على الجانب الغربي لنهر دجلة وعلى الضفة اليمنى لنهر الإسحاقي، والذي يمر من أمامه، بناه الخليفة المعتمد اخر خلفاء بني العباس في سامراء على ربوة عالية من التلال قبل العودة بالعاصمة إلى بغداد والذي بناه أبو الحسن علي بن يحيى المنجم للخليفة سنة (263 ه_ / 876م) وأكمل بناءه سنة (269 ه_ / 882 م ) ، وكشف عن تفاصيل القصر المعمارية من قاعات وغرف وممرات عند التنقيب فيه تحيط به ساحة مسورة
ص: 529
بسور هدم أغلبه(1)، (صورة رقم 3).
(8) قبة الصليبية: تقع إلى الجنوب من قصر العاشق على ربوة عالية، وهي على شكل بناء مثمن ، تعلوه قبة، ويحيط بالبناء أبنية على شكل الصليب، وسماها البعض (السليبية) وتعني الأم التي فقدت ولدها، بنيت بأمر من أم الخليفة المنتصر الذي مات مسموماً سنة (248ه_ / 862م)، ودفن فيها كما دفن إلى جانبه الخليفة المعتز بالله المتوفى سنة (255 ه_ / 868م) والخليفة المهتدي المتوفى سنة (256 ه_ / 869م) (2) ، (صورة رقم 4 ) .
(9) حير الوحوش : بناها الخليفة المتوكل عند توسيعه لمدينة سامراء، وهو عبارة عن حديقة للحيوانات الوحشية ،والغزلان لا تزال آثار السور الذي كان يحيط بالحديقة باقية، ويبلغ محيطه (30 كم) وسير له الخليفة نهراً سمّاه نهر النيزك يسقي حدائقه، وعثر بداخله على آثار أبنية وكانت البركة التي وصفها البحتري في قصيدته المشهورة في حدوده الغربية وبجانبها آثار قصر كبير يسمى المشرحات (3) (خارطة رقم 7).
(10) ساحات سباق الخيل وتل :العليق تقع إلى الشرق من قصر الخلافة وتتألف من ثلاث ساحات، تقع أمام تل العليق من الجنوب، اثنتان منها ذاتا شكل بيضوي، الأولى تبدأ من أمام قصر الخلافة وباتجاه الشرق، والثانية بيضوية الشكل أيضا وتبدأ من أمام تل العليق وباتجاه مدينة سامراء الحالية، فكان المتسابقون ينطلقون بوقت واحد في هذه المساحات البيضوية ويلفون حولها ويعودون إلى نقطة البداية لمعرفة الفائز ، أما الساحة الثالثة فتقع بجوار الساحة الأولى من الجنوب وتألفت من أربع دوائر متساوية المساحات والشكل، وتلتقي
ص: 530
في نقطة واحدة بالوسط، وكان الفرسان ينطلقون من نقطة الوسط وكل منهم يأخذ دائرة معينة، وبأسرع ما يمكن ليعود الفائز الأول وهو يحمل قصبة السبق إلى نقطة الوسط.
كان الخليفة يجلس على تل العليق ليشاهد المتسابقون، حيث أعد له بناء فوق سطح التل ليكون أشبه بمقصورة للجلوس كشفت عنها التنقيبات (1)، (خارطة رقم ).
(11) الاصطبلات تقع على بعد حوالي (15كم) إلى الجنوب من سامراء على الجانب الغربي لنهر دجلة، بناها الخليفة المعتصم لعزل الجيش عن العاصمة، بنيت لتكون معسكراً كبيراً وثكنات للجنود وساحات للخيم ومراع للخيل، ويحيط نهر الإسحاقي بجهتي المعسكر الغربية والجنوبية ويغذيه بالمياه، يتألف البناء من ثكنات للجيش تسع إلى (250 الف جندي) واصطبلات للخيل تسع إلى (160 الف حصان)، وكانت فيه ساحات كبيرة استخدمت كمراع للخيول وترويضها، واقتطع شارع سامراء - بغداد وسكة الحديد من أرض المعسكر، ولا تزال آثار الأسوار قائمة إلى اليوم (2).
ص: 531
الصورة

ص: 532
الصورة

ص: 533
الصورة
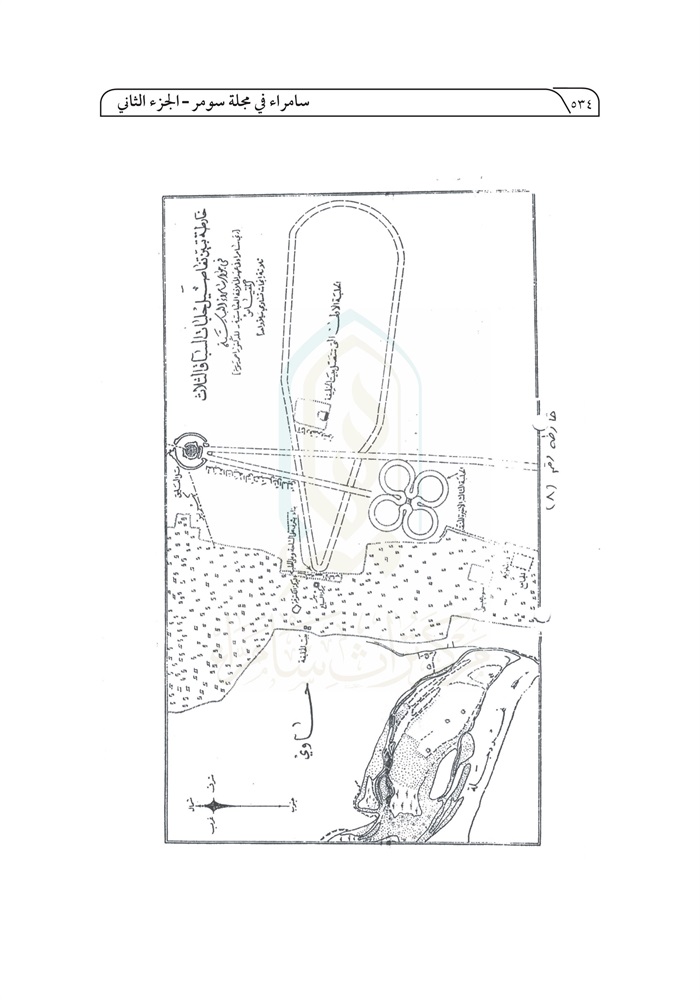
ص: 534
الصورة
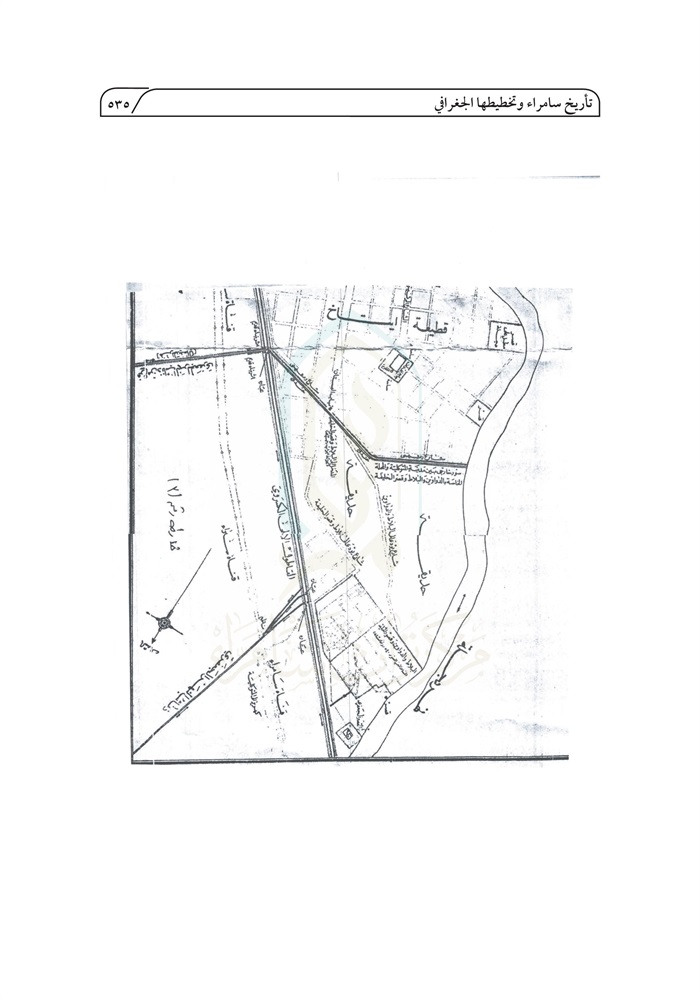
ص: 535
الصورة
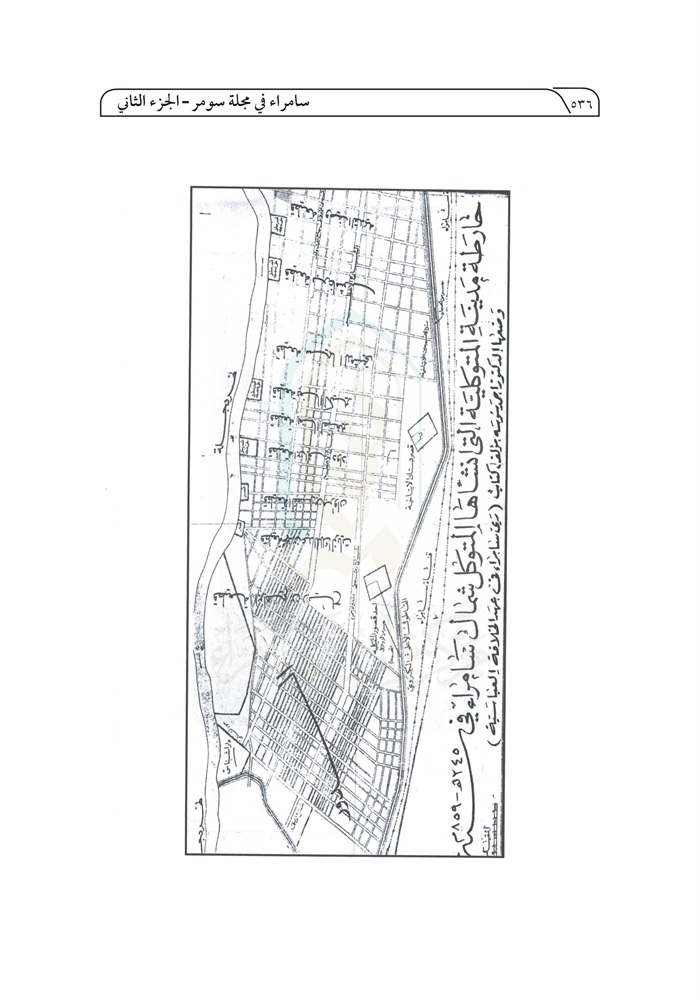
ص: 536
الصورة

ص: 537
الصورة
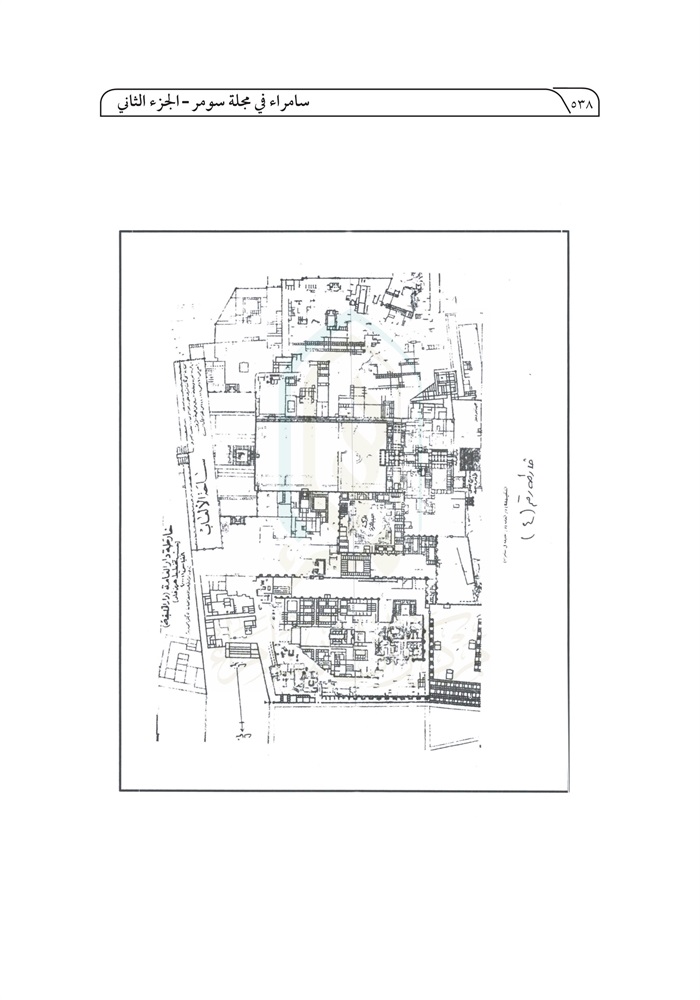
ص: 538
الصورة
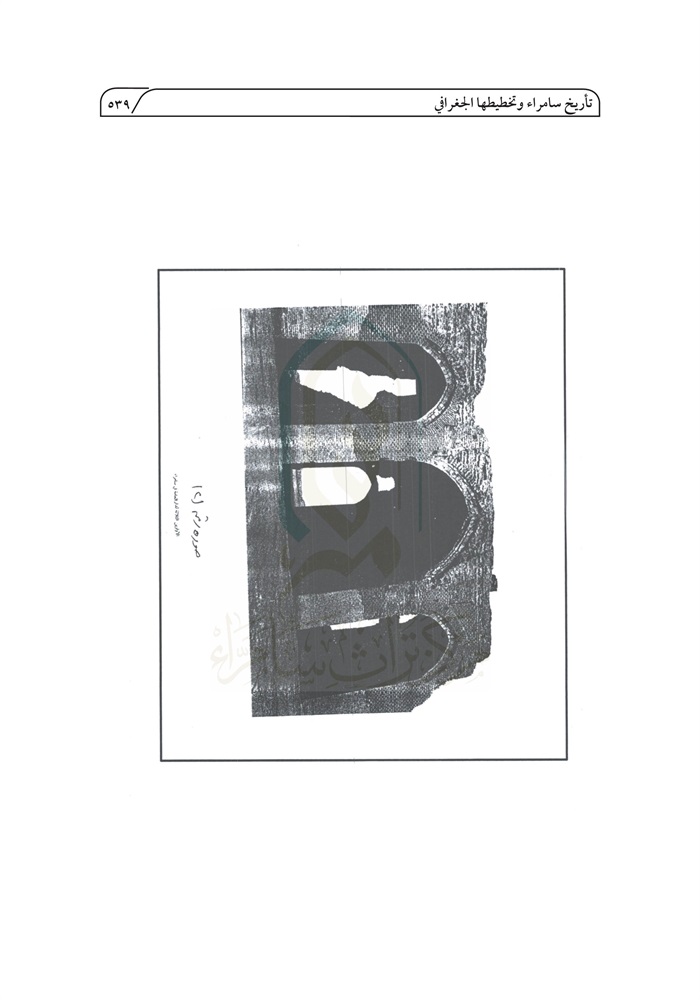
ص: 539
الصورة
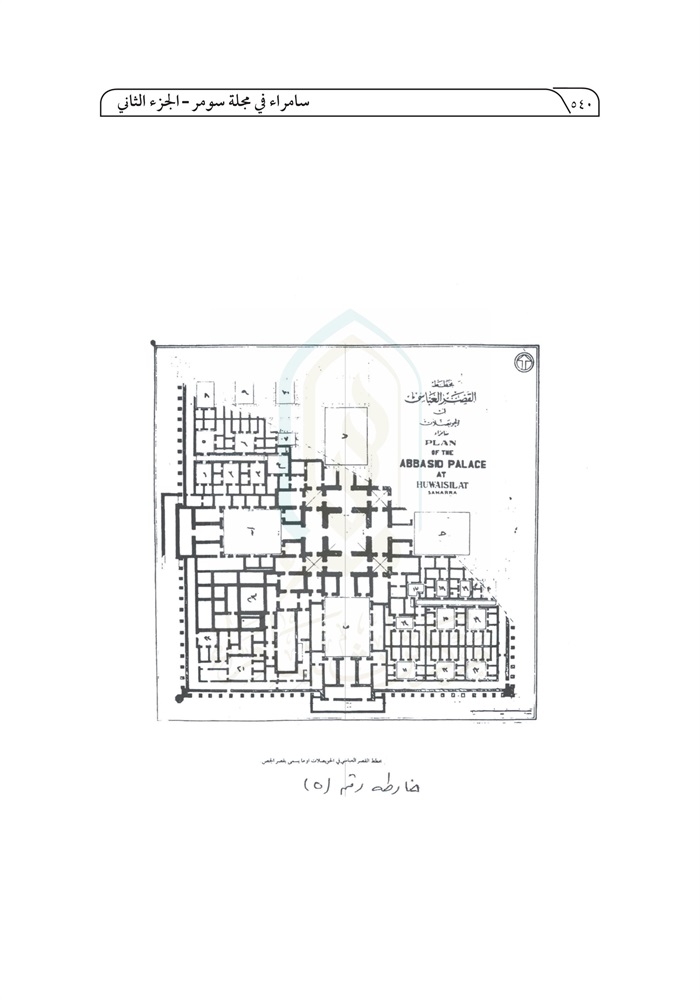
ص: 540
الصورة
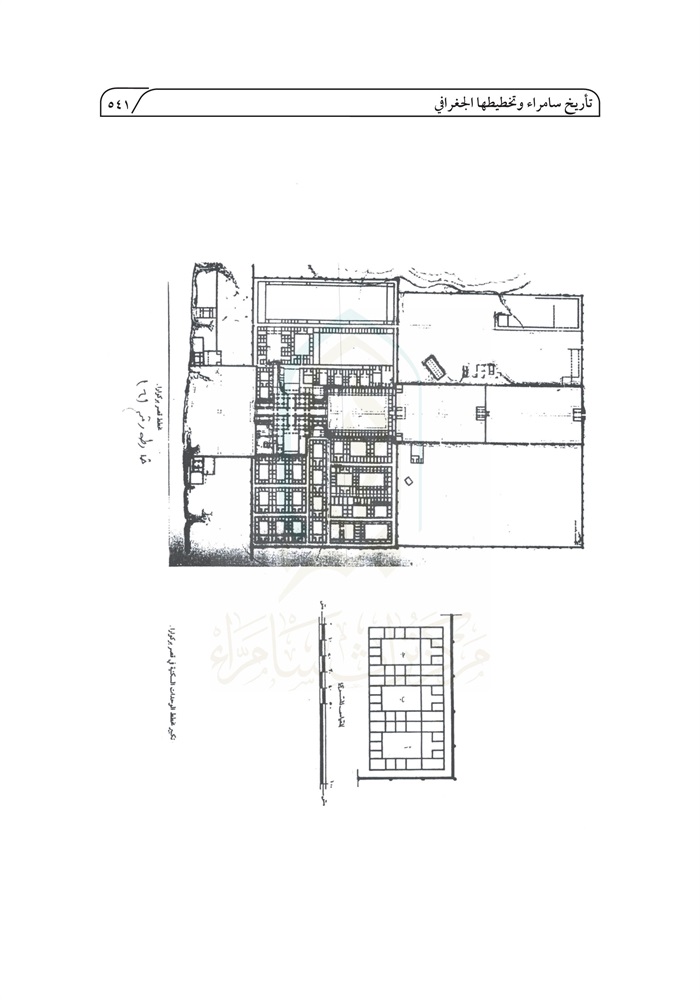
ص: 541
الصورة
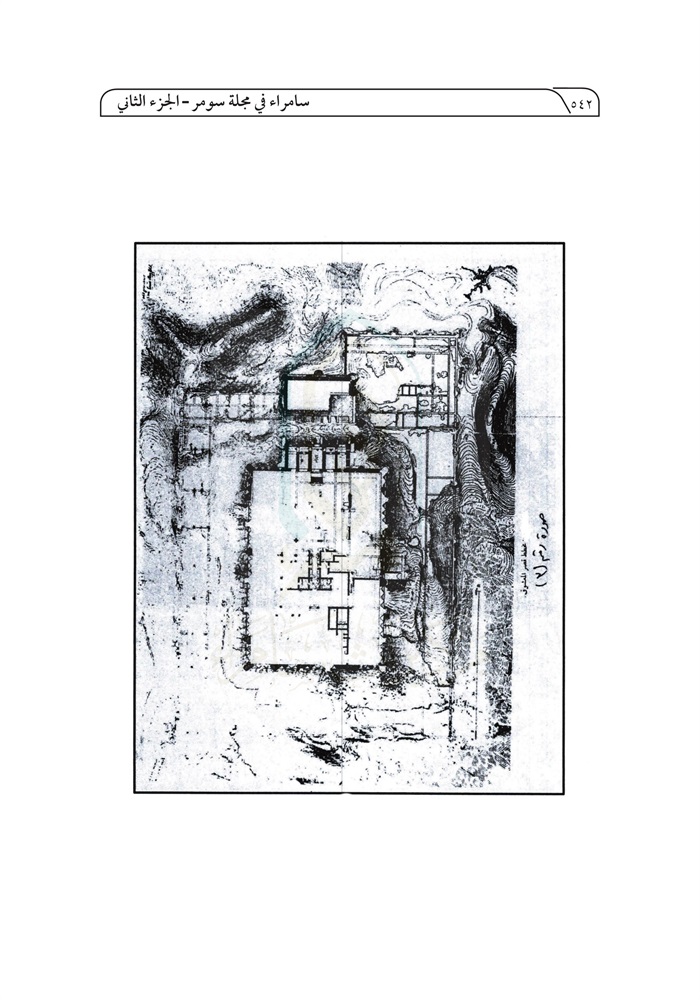
ص: 542
الصورة

ص: 543
الصورة

ص: 544
الصورة
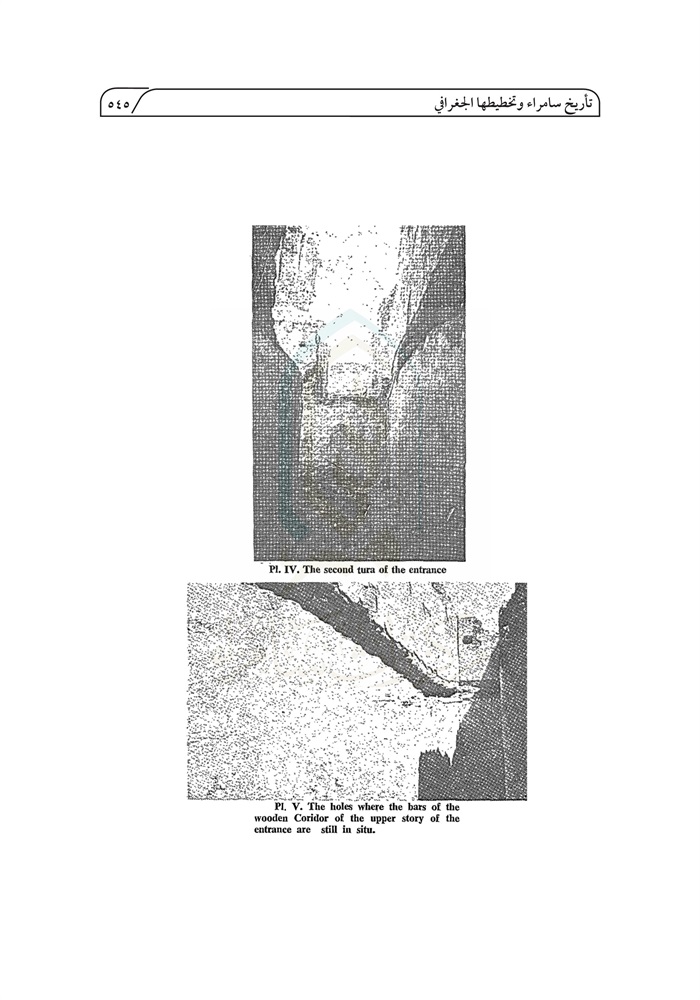
Pl. IV. The second tura of the entrance
PI. V. The holes where the bars of the wooden Coridor of the upper story of the entrance are still in situ.
ص: 545
الصورة

Pl. II. General View of the newly discoverd entrance.
Pl. III. Inside View of the entrance.
Pl. I The new entrance in the gateway block discovered in 1966.
ص: 546
الصورة
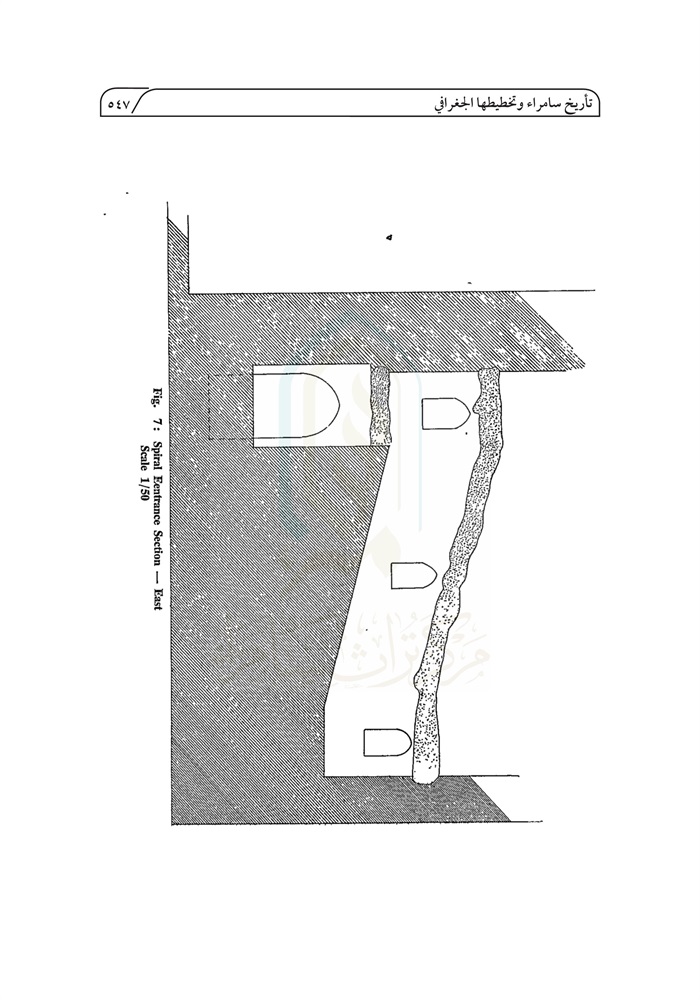
ص: 547
الصورة

ص: 548
الصورة

ص: 549
الصورة
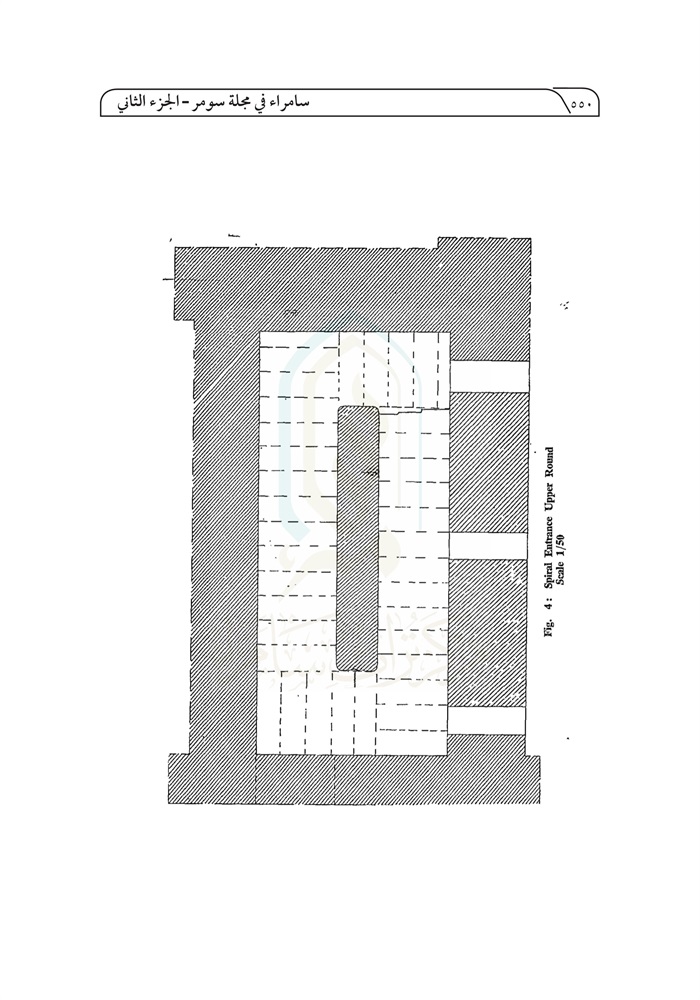
ص: 550
الصورة
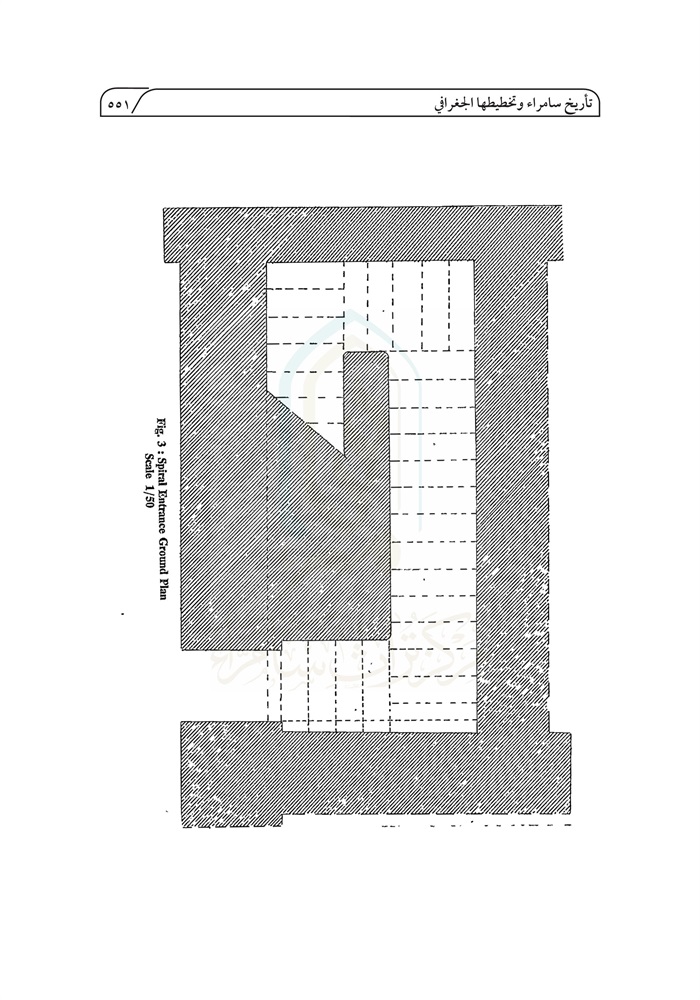
ص: 551
الصورة
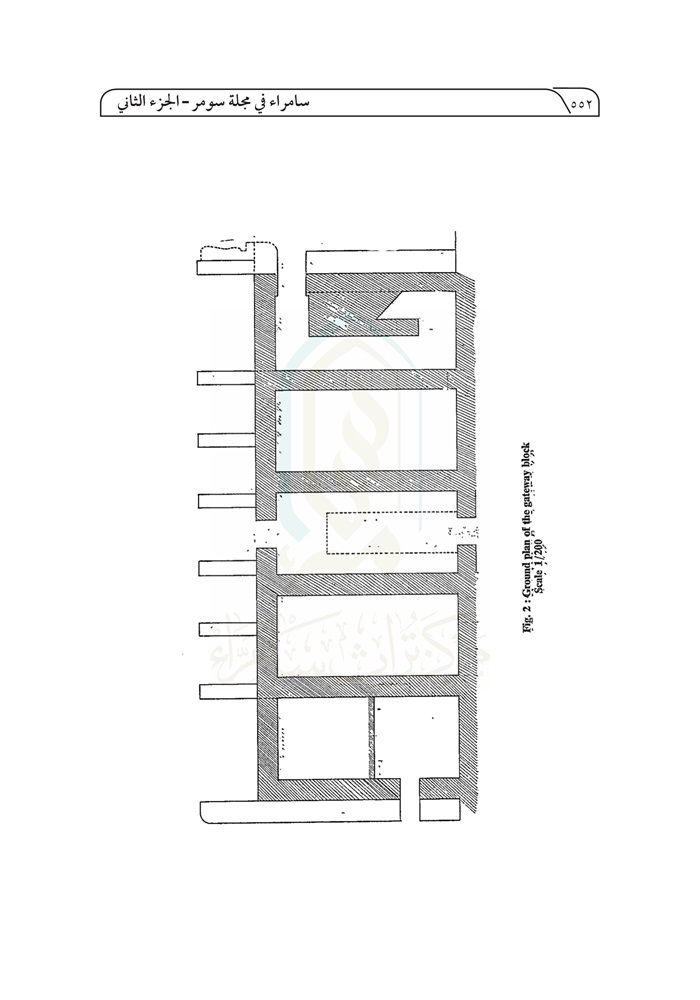
ص: 552
الصورة

ص: 553
ص: 554
ص: 555
than one main entrance(1).
ص: 556
of the Tigris river(1) where he had his Ashiq Palace built later on.
Al-Muwaffaq's domination over the state is confirmed by the fact that he confined Al-Mu'tamid to his palace in Samarra, af- ter bringing him back from Haditha(2).
The relationships between Samarra, the Caliph's city and Al-Muwaffaq's Baghdad were not verily friendly, since in 272 A.H the people of Samarra stopped the wheat and other provi- sion shipments coming down to Baghdad from the north, and thus engendered a sharp increase in prices. Baghdadi people's reaction would similarly be preventing soap, date and oil from passing to Samarra(3).
On the other hand, Al-Mu'tamid's continuous fear from the Turkish danger was strong enough to make him think of as forti- fied and secluded a palace as could be, in order to withstand the possible riots the Turks might stir against him(4).
The remains of the building suggest that it was intended to be a defensive castle as well as a residence. The indicated fortifications are those of the extraordinarily bastioned walls which are surrounded by a ditch to be watered by the Ishaki river(5).
Arrow-slits, of which none is left, are still likely to have existed.
That the spiral-bend entrance is the only one leading to the main internal parts of the palace is a suggestion sponsored by the belief that the palace was intended to be a fortified one, for its generally acknowledged that a fortified building has no more
ص: 557
meter and then make another turn east, after which the corridor is as long as its parallel 5.05 m. long one is. (fig. 3, pl. III). Still adopting the same another turn east, after which the corri- dor turns north and climbs up, along another thirteen meters, to a small wooden bridge, which, indeed marks a second-storey corridor, (fig. 4, pl.1. IV). This top corridor originally made of wooden. blanks resting on wooden bars, is no longer in exist- ence(1). The holes the bars left onto the walls sponser our sup- position that a Wooden corridor was there to lead to an interior entrance of the palce still in situ (pl. V).
The attractiveness of the entrance lies principally in the unique combination between the spiral entrance and the bend entrance, notoriously notified in both pre-Islamic and Islamic buildings.
Spiral entrances generally remind us of minarets and towers, while bend-ones are typical of castles, citidals and fortified city- gates(2).
This unique construction of the entrance stimulates one's wonder about the function the architect expected his entrance to achieve. Before discussing this question, one may find it rel- evant to refer to the circumstances in which the whole palace which was erected.
Al-Mutamid, history confirms, feared his brother's ambi- tious aspirations, since the latter was in full command of the state's various affairs(3). We also know that, in 264 A.H., when Al-Muwaffaq (for this was the brother's. name) came to Sama- ria Al-Mu'tamid averted him and camped on the western bank
ص: 558
one may find it essential to examine the added parts the later addi- tions mainly consist of two halls the entrances of which remained undiscovered until the Iraqi Department of Antiquities started ex- cavating the palace in 1965, when an access was discovered leading, through a 6 m long corridor(1), to a rather small, yet very high and finely preserved chamber measuring 5 x 6 m. fig. 2). This chamber does not cover the whole space of Herzfeld's first hall. There must be another one annexed to it on the northern side, to which no entrance has hitherto been discovered.
The hall on the other extreme, which, according to Ilerzfeld's description, has three high windows, remained until it Was excavated in 1966, full of piles of debris, originally materials of collapsed parts of the building Therefore, it was impossible for Herzfeld or anyone else to be positive about this hall, unless the debris piles were completely cleared out This Was factualized by the Iraqi Department of Antiquities, who excavated the place, clearing out all debris both from inside and outside. The excavation resulted in the discovery of a 2.42 m Wide entrance in the eastern wall of the hall (pl. 1). The southern edge of the entrance is 18 m away from the main northern facade; while its other edge is only 3 m. away from the northern edge of the block (fig. 2, pl. II)
This entrance is 3 m. deep actually constituting the thickness of the outer wall, at the end. of which starts the 20-degree ascen- sion of a corridor 2.20 m. wide and 5.05 m. long. This corridor turns south forming a right angle, to straighten for about thirteen
ص: 559
possibly carried on mules to the inner parts of the palace The entrance may, on the other hand, he simply for the movement 'of servants, guards and attendance at any rate, regardless of the architect's intention, We have examples of such an entrance, namely in Ukhaidir, though it differs from this one, for in that links it two interior parts.
The neighboring two halls, the measurements of which are the same as those of the central one, show no entrance or window whatsoever. These two halls were obviously built to extend the space of the basic ground of the palace; that is, the roofs of the halls Would add to the general extend of the building. This conclusion is based on the fact that the whole building stands on a platform extended on several natural hills(1):
The gaps amidst the hills were filled in whith debris, sand and soil, gathered from the surroundings. The variation in the depth of foundations, discovered through the serial excavations of the whole. palace, stands strong enough a proof for this theory. While in some spots, the foundation is only 80 cm. deep, in others it dives down to 6.20 m. This indicates that the Foundations were dug either before or after the filling in of the gaps, i.e. if the digging look place before the filling, the filling would necessarily have gone down and uphill along with the virgin soil; or, even if the gaps were first filled in, the walls to be erected were still high enough to demand strong foundations which could not he attained but by getting down to the virgin soil. The number of hills covered by the palace building is, however, not easy to guess.
Having finished with the original part of the gateway block,
ص: 560
block is 41:50 m wide. The east and west sides of the block end at the niches of the northern facade. According to Herzfeld, the gateway block is divided into five parallel halls all but the central one, being subdivided into two equal halves(1). In the last room on the eastern side of the block, there are three small, rather deep windows, 75 cb-wide each (Fig. 1) (2).
In his plan, Violet displays almost a similar division of the gateway block to Herzfeld's i.e. five parallel halls, but no subdivision or windows are marked out(3). Neither of the two scholars, however, informs us whether the block is original or a later addition to the building.
During the excavations of the Iraqi Department of antiqui- ties, it was proven that only the three central halls were original, while the rest of the block was added sometimes later(4).
Among the three central halls which, as abovementioned, constitute the original part of the block, the middle one is the most significant, showing a rather peculiar access. Five meters ahead from the exterior access, a 20 m. long rump starts its 25 degree ascension to an interior one This other access, which is 2.05 m In higher than the ground level, leads to some possible a celler, not yet clearly excavated.
The function of this type of entrance, obscure as it still may seem, can suggestively be facilitating heavy load transportation,
ص: 561
merely limited to the central area, while the other parts of the palace received only few scattered sounding trenches.
According to Herzfeld measurements, the palace is a rectangle enclosed by bastioned walls which measure 139.8m from north to south, and 93.2m from east to west. The enclosure has four corner towers, six intermediate ones on each of the eastern and western sides and two others of the north. The northern side has only two intermediate to wars because it is occupied by a projecting gateway block.
Before Herzfeld's excavations commenced, no considerable evidences had remained from the interior. Everything had been frightfully annihilated.
Herzfeld's investigations, incomplete as they are(1) owing to the hastiness that marked his excavations, are greatly contradicted by the results of the excavations conducted by the Iraqi Department of Antiquities(2). These final excavations provel that the interior of the palace was not divided lengthwise into three parallel strips as suggested by Herzfeld's(3) Such strips can be seen in Al-Mshatta palace of the Umayyad Period. Yet they seem to have some similarity with Ukhaidir, Balkuwara and Huwaysilat plans.
The plan of the exterior of the palace, the design, ornamentation, building materials etc., are all merely connived at in this paper, while the gateway block will be the part upon which all
attention is focused.
Projecting 26 m. into the surrounding ditch, the gateway
ص: 562
A.D.), including the building period.
However, archaeological evidences suggest that the palace remained in use even long after the abandonment of Samarra by the Abbasid caliphs(1).
Al Ashiq Palace was first mentioned by Baron von Oppenheim, who ascribed it, without concrete evidence to the era of Harun Al-Rashid(2). Oppenheim's View Was later adopted by Saladin(3).
Calling attention to the palace, Miss Bell suggests that Al- Ashiq belongs to the Samarra era, but says nothing about the Caliph for Whom it was set up(4)
Violet and Herzfeld were the scientific pioneers in the field. The former's study(5) provides us with a, ground plan as well as several elevations and sections. Yet, the author, we the title of his work suggests, attributes the palace to Al-Moutasim billah, the founder of Samarra.
We are much grateful, however to the letter, the late Ernest Herzfeld for his brief excavations in the palace. The outcome of his thirteen-day digging (May 30th to July 11th, 1911), was published in his "Preliminary Report" in 1912 (6)which includes a, very well-known ground plan and an excellent topography of the site(7).
In his plan, Herzfeld marks out the digging spots which were
ص: 563
1974
By
Dr. abdul aziz hameed
University of Baghdad
In Islamic architecture, no standing monuments after Mshatta and Ukhaidir received such great attention as Al-Ashiq Palace of Samarra did(1).
This attention was certainly due to various factors, some of which lie in the fact that, at the beginning of the century, the building was still in a fair state of preservation, particularly the main enclosure. Besides, the Palace uniquely stands within easy reach; only 125 km. north of Baghdad on the main road to Musil. After all, the early dating of the palace, for it was mentioned by such great Arab historians. and geographians as Yaqubi(2), Muqadasi(3), Jaqute (4), Ibn Jubayr(5), and Ibn Battuta.
Al-Ya'qubi, the earliest Arab geographian, tells Us that the palace was built for Al-Mu'tamid billah, the son of AlMutawek- kil, who resided in it until his affair fell into disorder, when he moved to Baghdad and later to Al-Mada'in (6).
Thus, Al-Mu'tamid abided Al-Ashiq for no longer than fif- ty-two months, from 265 A.H (878 A.D.) to 269 A.H. (882
ص: 564
image

ص: 565
image
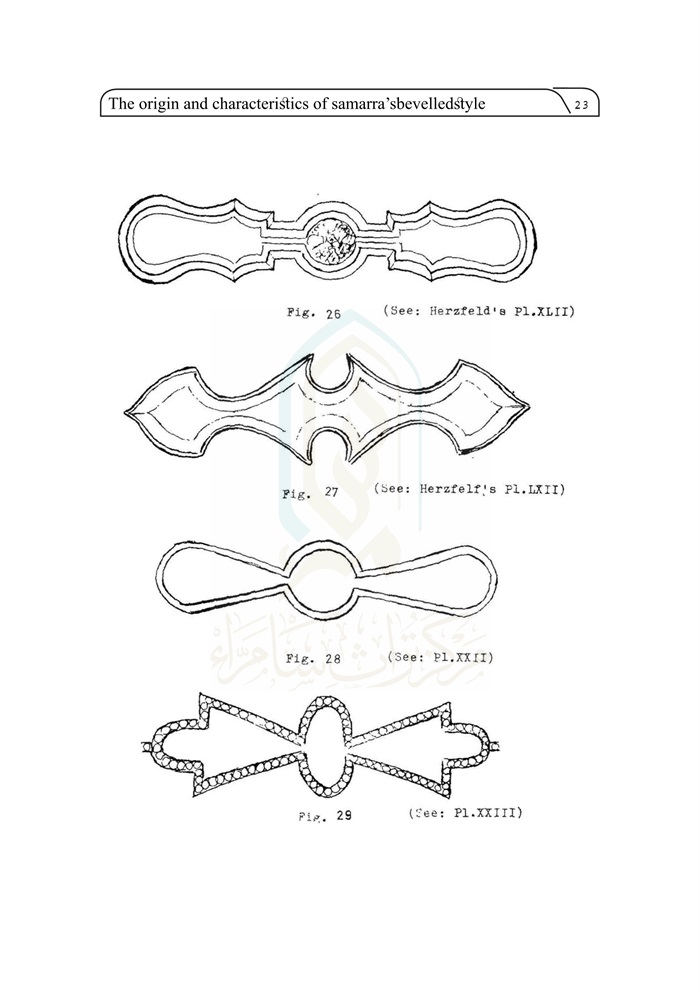
ص: 566
image
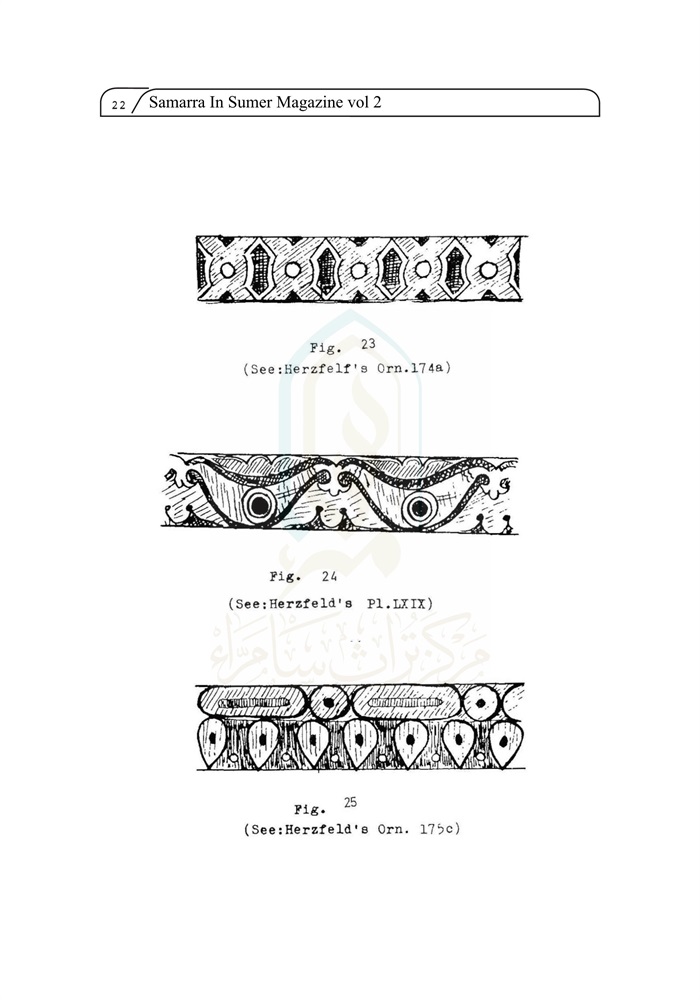
ص: 567
image
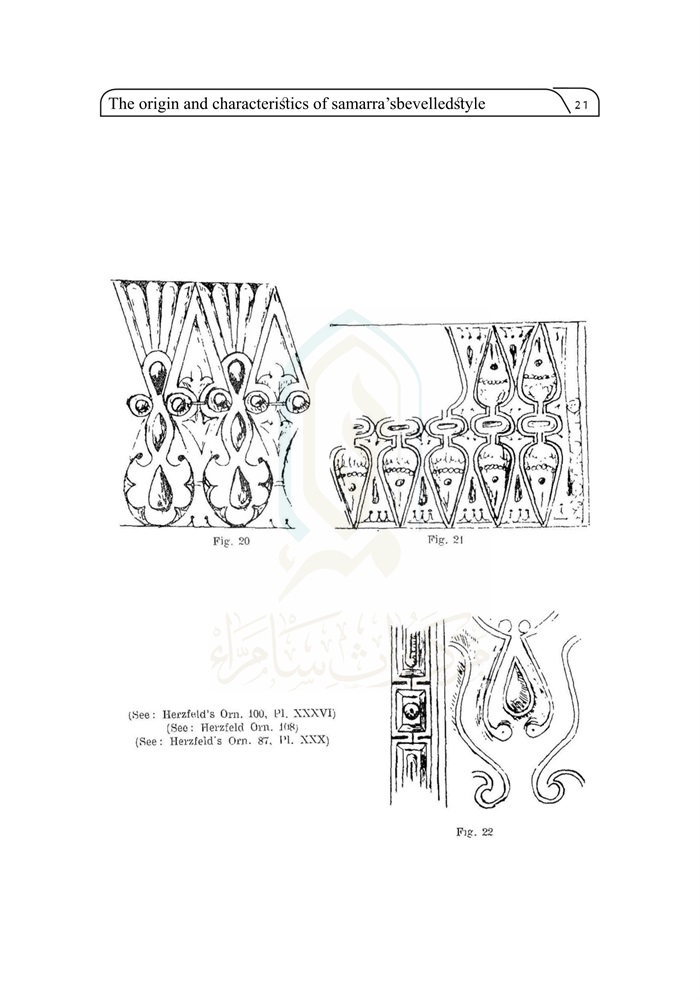
ص: 568
image
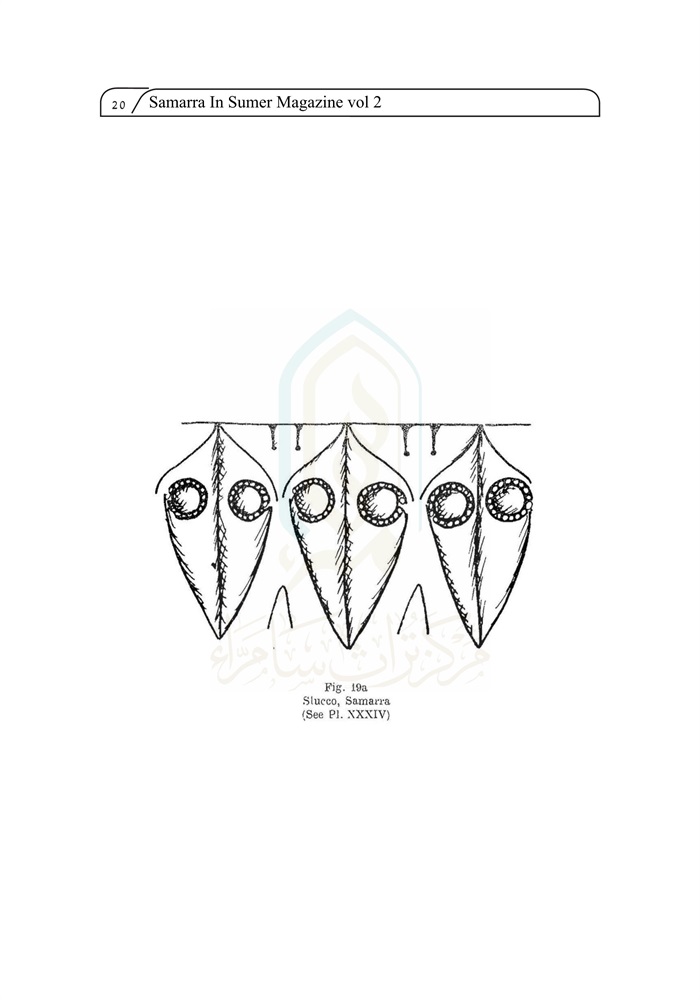
ص: 569
image

ص: 570
image
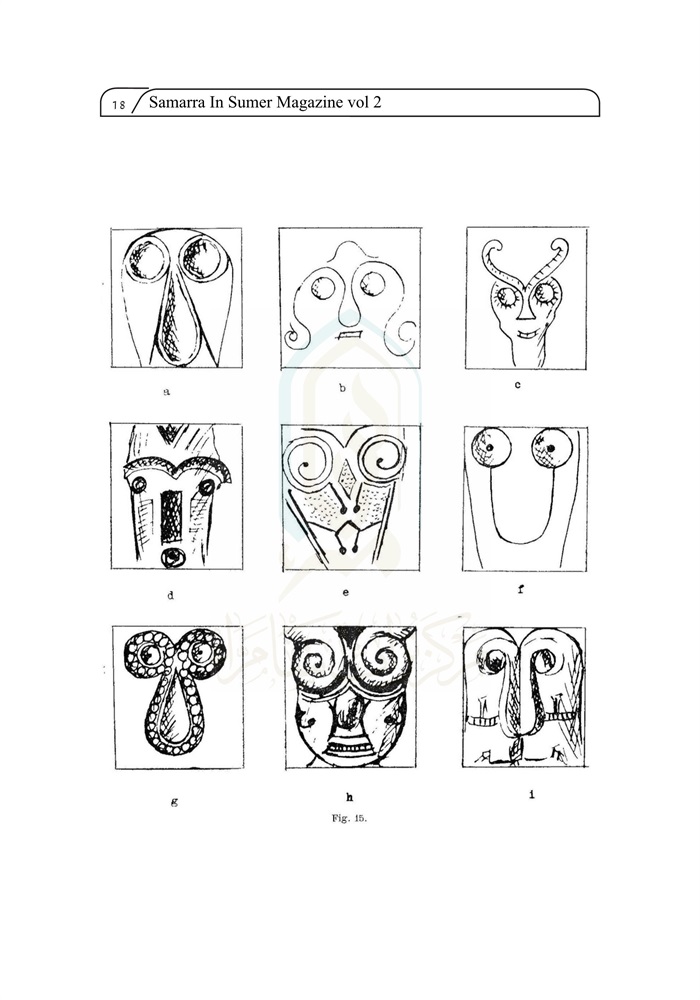
ص: 571
image
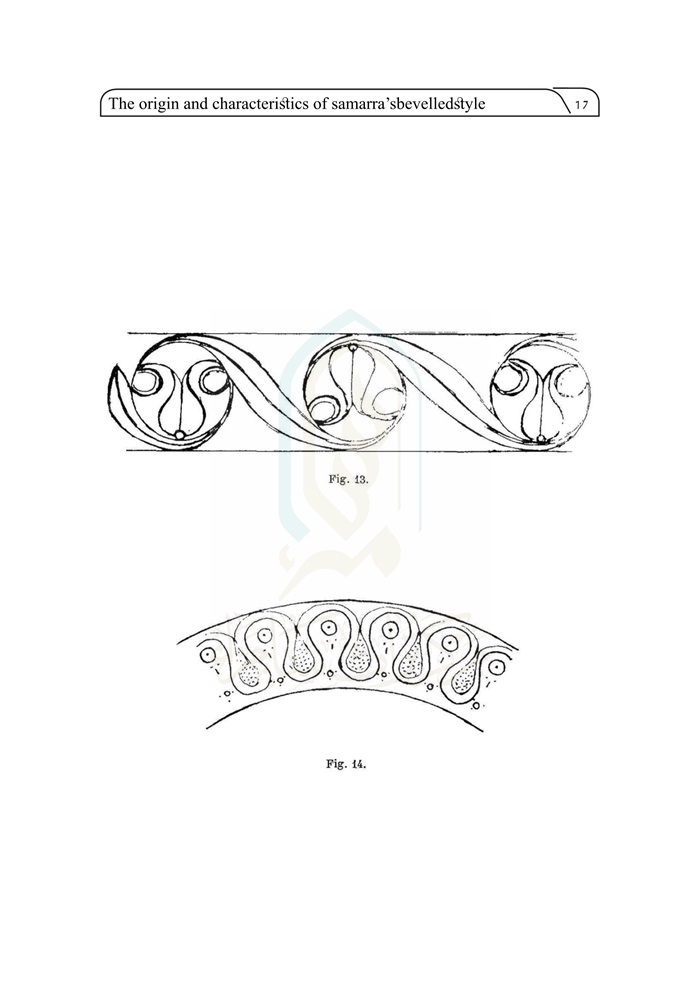
ص: 572
image
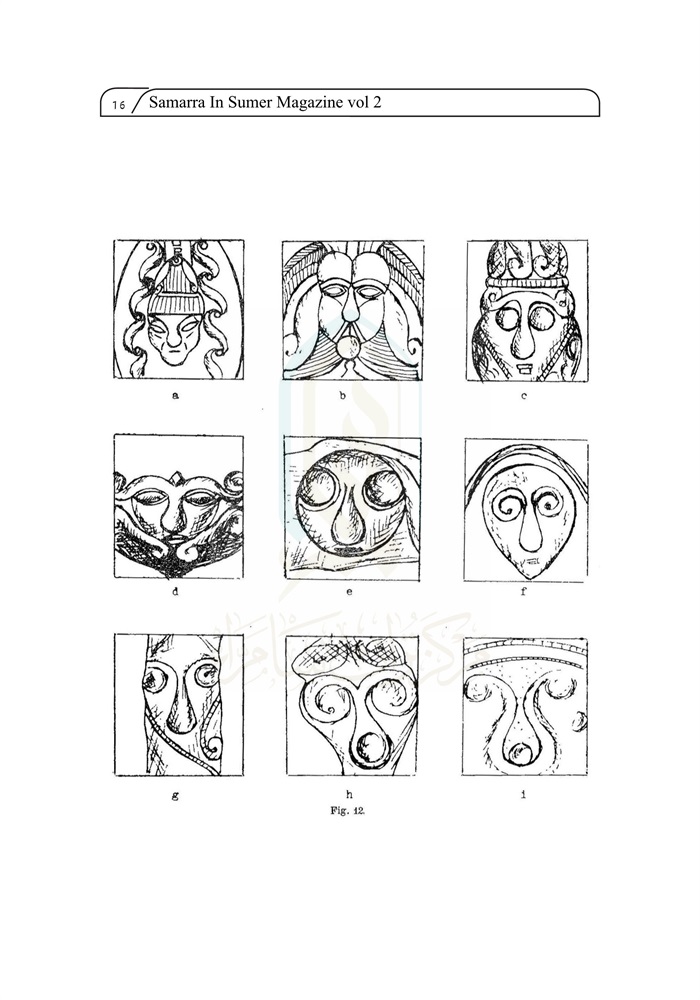
ص: 573
image
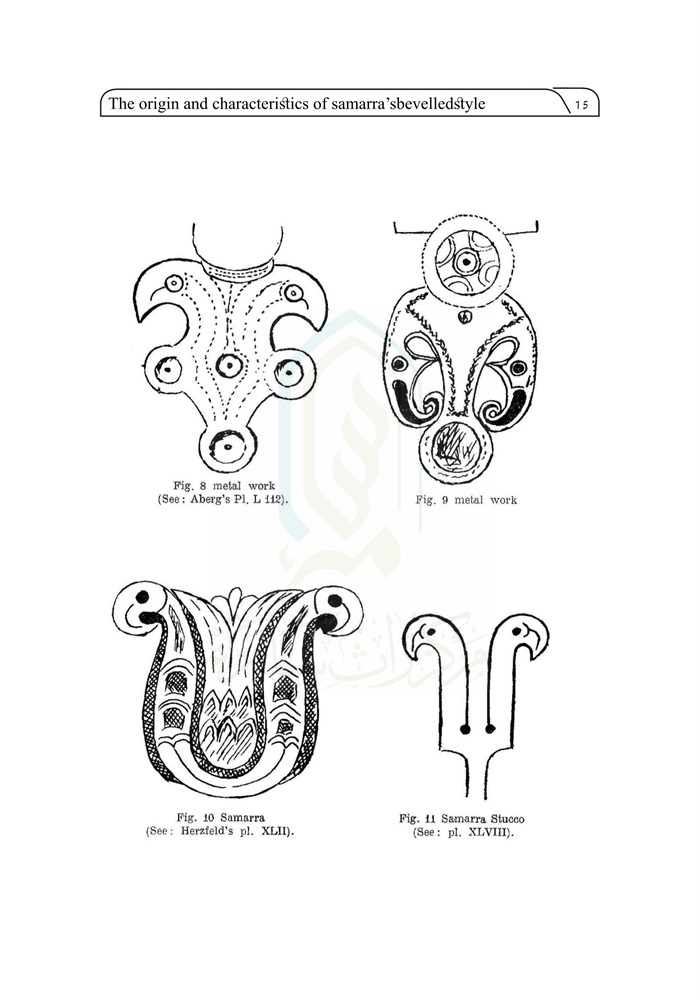
ص: 574
image

ص: 575
image
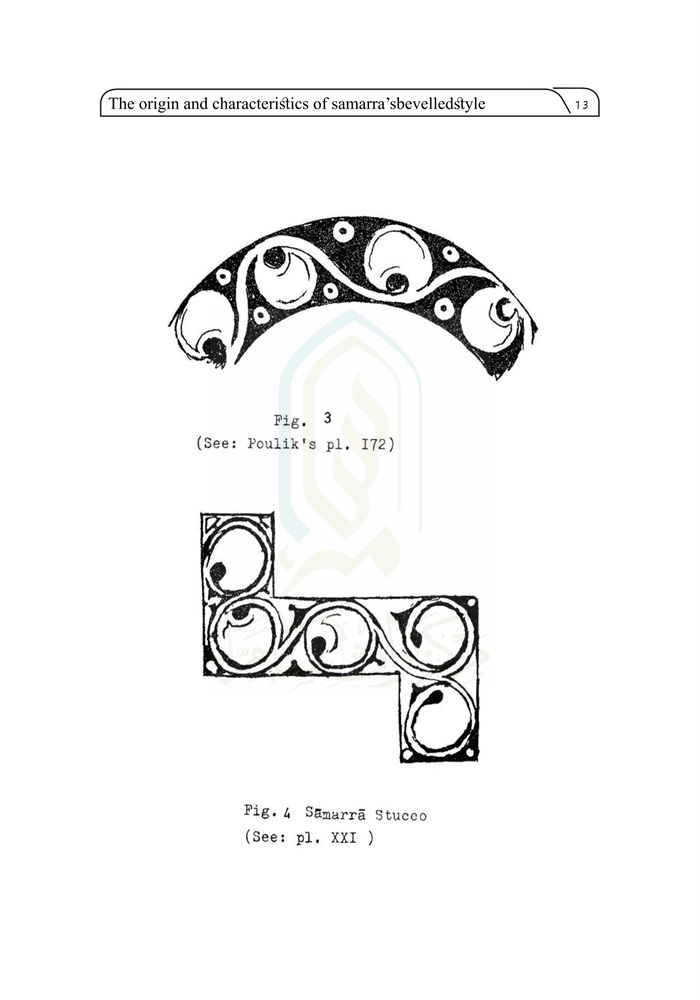
ص: 576
image
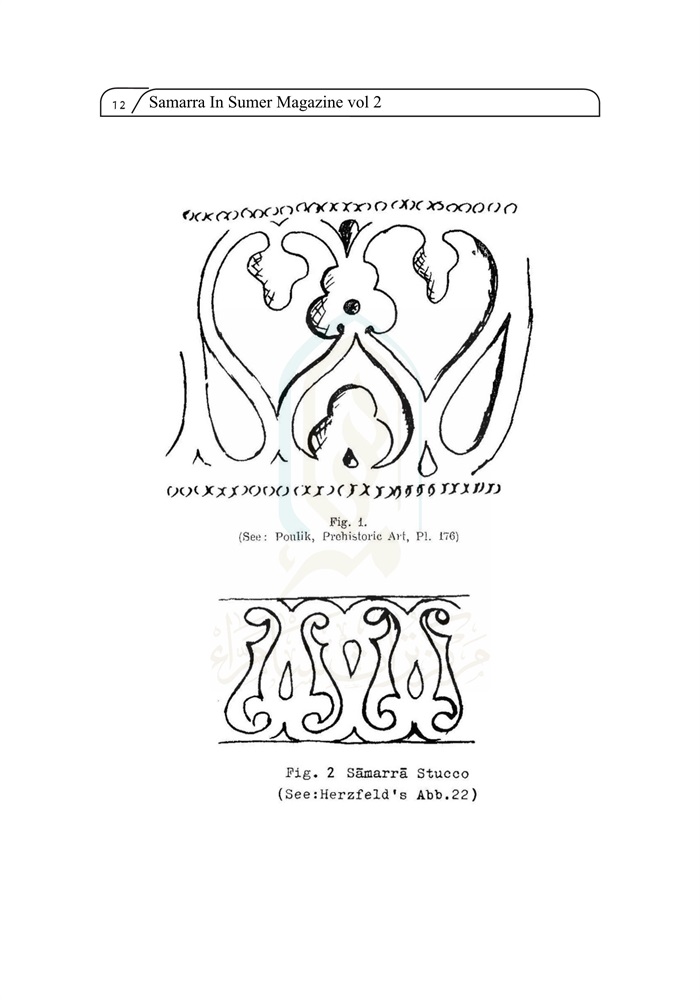
ص: 577
stract in forms to develop back to the traditional motifs of the early style C.
To conclude, I suggest it is possible not only that the beveled technique was inspired by the Turks of central Asia, but also that many of their personal objets were used as models by the samarran stucco craftsmen. If this was so, it probably happened when Turkish prestige reached its zenith from the middle period of samarra onwards(1) (2)…
ص: 578
art. Examples of this motig appearing in samarra stucco ornament are ilustrated in Figs. 16-19.
There is no evidence that the hevelled technique appeared on objects other than metals prior to the samarra era. Thus, it is possible that the appearance of the technique in samarra was actually a direct immitation of metal work, particulary when one notices that many odd devices which superimpose style C motifs are very strange to the actual stucco patterns. Thes devices which are either drop-shaped, circular or elliptical in shape recall instantly precious stones inlaid in personal ornaments. They appear not only in stucco (Figs. 20, 21, 22), but also in samarra's wood decoration. (Figs. 23, 24, 25).immitation of personal jewelry in stucco can also be supported by the fact that the shape of style C repeated units (Figs. 26, 27, 28, 29) are similar to braclets; such as braclets brought to light in Hungarian nomad burials of 5th -9th centuries A.D. (Figs. 30, 31, 32, 33).
The theory of kuehnel, consequently, should be accepted be- cause of the new data obtained through the recent excavations in Central Asia and in eastern and central europe, as has already been discussed, particularly when we remember that in com- paring stlye C. Patterns with the other tow styles, one cannot but agree with Herzfeld in his suggestion that the former style is totally different from the latter styles, whether in patterns or in technique(1). It is also rather obvious that it is not difficult to demonstrate how Style A through a course of gradual evolution ended in Style B(2). The final stages of the evolution me too ab-
ص: 579
with scrolls occuring in samarra style C (Fig. 4). Finally, I have chosen a tenth century Hungarian engraved bone clasp. (Fig. 5) which shows a similar design to those of samarra (compare with samarra's figs. 6 and 7).
Figural representation played a great role in the Nomadic decorative art of the migration period. Among the animal motifs the eagle's head was particularly very popular. It occurs in singular or in double form, especially in their horse trappinps and among the decorations of their personal objects, such as clasps for belts. Here again no analogies of such motifs are to be found in the art of the presamarran era of the middle-east: whereas at samarra the motif is to be found in a very similar fashion to its representation in the no madie Art. For comparison I have chosen two Nonadic belt clasps of the 6th-8th centuries A.D. (Figs. 8. 9) which show great similarties to motifs that appear among the decorations of samarra stucco ornaments, such as the ones illustrated in Figs. 10, 11.
The "hmnan face" also occurs very frequently among the ornaments of the xomads. It seems to be derived originully from Celtic Art, Where it appears in naturalistic Form (Fig. 12a, 12b). or in stylized fashion (Figs. 12c,12f. 12g, 12i) (1). The motif is also represented in scrolls (Fig. 13) and in hands (Fig. 14) (2). In the 5th-7th centuies A.D. of the nomadic period the motif is mainly represnted in stylized Fashion (Figs. 15a, b.c. d. e. f. g. h. i). The "human face" motif. Which never occurs in sassanian, pre-Islamic Syrian, or umayyad art, not only unmistakably appears in a very similar fashion to its representation in Nomad
ص: 580
mentions. Some of the objects he illustrates show motifs. bearing great resemblance to motifs appearing on Hungarian objects of the same period, such as the five-petalled palmett(1), a type of palmette which occurs in neither Sassanian nor umayyad ornament. but appears later at Samarra. Kischlev also calls attention to the many Turkish patterns and motifs which were known in Europe as far as Hungary. particularly those attributed to the 4th-8th centuries AD(2). The excavations in the Nomad Hungarian and Slav burials of the 5th-10th centuries AD. revealed large quantities of ornamented metals objects(3), most of which show scrolls and other plant motifs as well as figural designs; a good number of thes designs show great resemblance to Samarra Style C, Whether in technique or in patterns.
An ornamented iron backet. for example, recovered from a Slav burial attributed to the second half of the ninth century A D, which showing an Openwork design of combined scroll and palmettes (Fig. 1) is very similar in design to some motifs appear in samarra is style C. (such as the one illostrated in Fig. 2) (4) also a nomadic bronze object attributed to the 7th century A.D. (slav Cluture) (5), shows a scroll (Fig 3) almost identical
ص: 581
technique, they were certainly not the last to use it before the Islamic period. It seems that from the days of the Scythians on- ward the technique became one of the main characteristics of Nomadic Art(1).
In Celtic Art, the technique reached a very high degree of perfection. in which most versions of the scrolls, the palmette and its variations, are executed(2). In spite of the Celt's disappearance in a period well before the Christian era, the style had lasted long after, particularly in places the Romans could not dominate such as Ireland. Scotland and Germany(3). Moreover, the many excavations carried out in Central Asia and Eastern and Central Europe during the last thirty Years or so. Brought to light many objects ascribed to the 6th-9th centuries A.D. showing not only the same bevelled technique but also patterns almost similar to those of samarra's 9th A.D. century.
Concerning the Turks, the Russians excavated a number of nomad Turk burials in several places northern and southern Altai. These burials Were found to contain good quantities of met- al objects, such as knives axes, various parts of horse harness, in addition to various personal ornaments in bronze, silver and gold(4). A study of these objects according to Kiselev indicates that they were massproduced(5).
Unfortunately, Kischlev illustrate very few of the finds he
ص: 582
ascribes its origin to East Iran or Central Asia(1). Strzygowski regards the bevelled technique appearance on some Roman and Byzantine metal-works either as imitation of Persian objects, or executed by Iranian craftsmen.
The bevelled technique occurs neither in ancient Mesopotamian nor in Greek ornament. As Strzygowski pointed out, the nomad Scythians, who during the last millenium B.C. roamed the vast steppe which stretched from the core fines of China to the banks of the Danube. were the first to introduce this technique(2). It appears in particular in their horse-trappings. Probably the reason for the invention was to show the reflection of the sun(3).
associated with the arrival of the Turks from Central Asia as bodyguards for the Caliphs(4). The theory of Kuehnel has not been warmly received. The reason for that is the gap of about one thousanrl years between the Scythian era and that of Samarra. added to the fact that the excavations which were carried out at Samarra brought no evidence to support Kuehnel in his theory(5).
But although the Scythians, who vanished around the third century before our era(6), were the first to introduce the bevelled
ص: 583
1966
The origin and characteristics of samarra'sbevelledstyle(1)
By
Dr. Abdul Aziz Hameed
Style C, as Herzfeld pointed out, is the style peculiar to Samarra. It appeared there for the first time; from there it spread to other parts of the Islamic Empire. The style is distinguished by two main characteristics: the bevelled technique in which the majority of its patterns are executed, and the palmette motif which forms the principle element of the designs.
The term "bevelled technique" is applied to the slant style of carving creating a sculptured plane with a soft flat modulation. Riegl was the first to draw attention to this peculiar technique, pointing out that it can be traced to the late Roman Art(2). Subsequently, he assumes it as a late classical heritage(3). Strzygowski, on the other hand, calling attention to the decoration of the kilts of some bronze knives and axe-heads from the Altai region(4),
ص: 584
المقدمة ... 7
الصيانة الأثرية في قصر العاشق في سامراء ... 13
التنقيب والصيانة في سامراء 1978 – 1981م ... 27
قصر الخليفة المعتصم في سامراء ... 81
دراسة حول صيانة الأسوار والمباني الإسلامية في سامراء ... 159
استدراكات تاريخية لمواقع أثرية القسم الثاني ... 169
استدراكات تأريخية لمواقع أثرية القسم الثالث ... 181
ببلوغرافيا عن سامراء ... 199
مشروع إحياء مدينتي سامراء والمتوكلية الأثريتين دار رقم (1) سامراء والشارع الأعظم ... 231
«التحليل المجهري لصبغات داخل أوانٍ فخارية» - من سامراء - ... 279
التنقيب والصيانة الآثارية في دار رقم (4) مدق الطبل ... 283
التنقيب والصيانة الآثارية في دار رقم (5) مدق الطبل ... 327
ساعة سامراء الشمسية ... 355
مشروع تطوير مدينتي سامراء والمتوكلية «مسجد سور عيسى» .. 367
البركة الدائرية داخل قصر الخليفة - سامراء تنقيب وصيانة ... 373
الكشف عن النافورة في قصر الخليفة المعتصم ... 399
حمام البركة الدائرية التنقيب في الدار رقم (3) الشارع الأعظم ... 431
تأثير الأساليب المعمارية للجامع الكبير بسامراء في عمارة جامع أحمد بن طولون بالقاهرة ... 451
صيانة بركة سامراء لعام 2002م ... 465
القبة الصليبية ... 483
أضواء جديدة في ريازة الأعمدة والأكتاف في جامعي سامراء الكبير وأبي دلف ... 491
تاریخ سامراء وتخطيطها الجغرافي ... 509
القسم الاجنبي
1-The origin and characteristics of samarra'sbevelledstyle... 5
2-New lights on the ashiq palace of samara … 25
ص: 585
ص: 586
ص: 587
Al-Askarieian Holy Shrine
Samarra Heritage Center
Samarra
In Sumer Magazine
vol 2
By:
Samarra Heritage Center
ص: 588